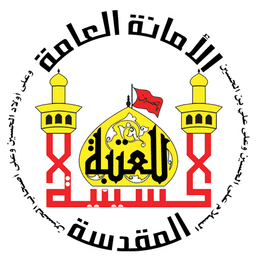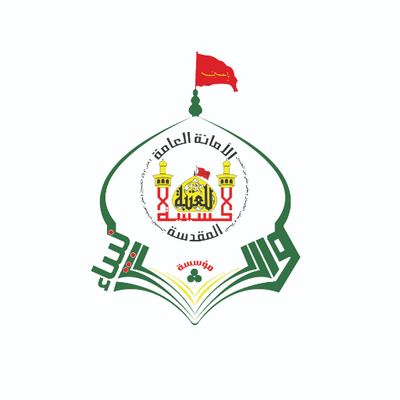المقدّمة
توجد سؤالات كثيرة تدور في خُلد كلّ عاقل تتعلّق بمنشئه ومصدره، ولماذا هو موجود في هذه الحياة؟ وما هو مصيره؟ وإلى أين يذهب من بعد دنياه؟
لقد تكفّل الشارع الإسلامي بمصادره المتعدّدة بالإجابة عن تلك الأسئلة المشروعة، واستثمر كلّ مناسبة شرعية لبيان الإجابة عنها بكلّ وسيلة عقلية متاحة للعامّة قبل الخاصّة، إجابةً اتّسمت بالبساطة وسهولة الفهم لكلّ عاقل وإن دنا مستواه العلمي.
ومن تلك المصادر القدسية التي تكفّلت بالإجابة عن تلك الاستفهامات هي النصوص الشرعية الواردة عن المعصوم× في زيارته للإمام الحسين×، وكان مصدرها الأوّل في المقام هو المصدر القرآني (نصّاً ومضموناً)، فقد تضمّنت تلك الزيارات المباركة حشداً كبيراً من آيات القرآن الكريم، وهذا إنّما يدلُّ على أهمّية الكتاب العزيز في بيان تلك المعارف الجليلة أوّلاً، وأنّه توجد علاقة وطيدة الأواصر بين القرآن الكريم والإمام المعصوم× ثانياً؛ فالمعصوم هو عدل القرآن وشريكه كما ظهر من الأخبار المعتبرة، والمعصوم هو الثقل المتمّم لمعارف القرآن وترجمانه كما صدر عن النبي الأكرم| في حديث الثقلين المشهور.
لأجله؛ خضتُ عباب هذا البحر اللّجي في هذا المقال المقتضب؛ طلباً لبعض كنوزه وثروته العلمية، مسترشداً مصادر الزيارة الحسينية المعتبرة في الكشف عن تلك الجواهر القرآنية، مع الاستعانة بأفضل مصادر التفسير الإسلامي عند كلا الفريقين.
آيات المعرفة العقدية
تشبّعت النصوص الخاصّة بالزيارات الحسينية والصادرة عن المعصومين^ بالآيات القرآنية نصّاً ومضموناً من رأسها حتى الذيل، وبعد الاستقراء لمصادر تلك الزيارات وجدتُ ثلاث مجموعات من الآيات المباركة تضمّنتها الزيارات الواردة عن المعصوم×، فالمجموعة الأُولى تضمّنت آيات وجوب شكر المنعم والعمل على التسليم له في قضائه وقدره، وأمّا المجموعة الثانية فقد تضمّنت آيات خاصّة بصفة التوحيد الإلهي، وتركيز الولاء للمولى جلّت قدرته ولأوليائه^، ويختمها مسك آيات معرفة المعاد وتفاصيل يوم الجزاء؛ حيثُ النعيم المقيم، أو العذاب الأليم جزاءً لكلِّ مَن كفر وظلم.
وبناءً على ما ظهر من نتائج بيانية قسمتُ المقال إلى ثلاثة مباحث علمية؛ تمهيداً لاستخلاص نتائج الاستعمال القرآني من تلك الزيارات المباركة.
المبحث الأوّل: آيات معرفة شكر المنعم والتسليم له
الاقتباس الأوّل: البدء بحمد الله
ابتدأت النصوص الخاصّة بالزيارات الحسينية بحمد الله والثناء عليه، كما استغرقت كلماتُ الرضا بهذا المصاب الجلل مع فداحة الخسارة أغلبَ مقاطع تلك الزيارات، وكانت تلك العبارات مستوحاةً من النصِّ القرآني أو مضمونه المعنوي.
لقد أكّد المعصوم× في خطاباته وأدعيته ومناجاته ونحو ذلك على ضرورة البدء بحمد الله وتكبيره؛ تنزيهاً له عن كلِّ ما لا يليق بحضرة جلاله، ومن تلك التأكيدات ما يذكره في زيارة مشهد سيّد الشهداء×، حيث نجده يستفتح ذلك بالحمد والثناء له}، والإقرار بالوحدانية الكبرى، فيقول×: «الحمد لله الذي لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً.... وخلق كلَّ شيءٍ»[1]، وهو ما تضمّنته الآية المباركة: (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا)[2].
وكما ورد في زيارته× هذا الاقتباس القرآني[3] من قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ)[4]، فكان جواب قولهم هذا من البارئ} في تتمّة الآية نفسها بقوله تعالى: (وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
هذا؛ وتحمل تلك الكلمات النورانية دلالات كثيرة، ومعان عميقة تُرسّخ في نفوس المؤمنين ومنها ما خطر في قلوب المفسّرين استذكار نعمة الهداية، التي تتجلّى بالإرشاد إلى أسباب الإيمان والعمل الصالح، وجعلهما نفس النعيم؛ لأنّ الإرشاد إلى ما يوصل إلى الحقّ إنّما هو هداية له، وتعني هدي الله إيّاهم ببعثته النبي الأكرم| إليهم، وتأييده بالمعجزات، فاتّبعوه مطيعين، ودلّ عليه قوله تعالى حكايةً عنهم: (لقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ)، مع ما يسّر الله لهم وشرح صدورهم للإيمان؛ فإنّه من تمام المنّة المحمود عليها، وذلك ممّا يؤذن بكبر منّة الله تعالى عليهم؛ ولذلك جاء الحمد مشتملاً على أقصى الميزات الواردة في سورة الفاتحة.
وممّا دلّ عليه قولهم: (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ) هو حقيقة بُعد هدايتهم وعُسر تحقّقها من دون التوفيق الإلهي؛ لكثرة المغريات والشهوات المانعة من تحقّق الهداية، فليس من السهل اهتداؤهم لولا أن هداهم الله ببعثة الرسل والأوصياء وحُسن سياستهم في دعوتهم[5].
إنّ نسبة فعل الحمد إليهم فيه دلالة على أنّ الله تعالى يُخلصهم لنفسه، فلا يوجد عندهم اعتقادٌ باطلٌ ولا عملٌ سيّء، فيصحّ منهم تحميد الله تعالى، ويكون مؤثّراً فيهم، فليس توصيفه تعالى مبتذلاً وسهلاً حتى يناله كلّ أحد.
أمّا قولهم الذي حكاه عنهم: (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ)، ففيه إشارةٌ إلى اختصاص الهداية به سبحانه، فليس إلى الإنسان من الاهتداء شيءٌ من دونه}؛ وبناءً عليه استوجب إظهار الحمد والثناء له جلّت أسماؤه عند افتتاح زيارة الإمام الحسين× بمنطق المدين والواله المسكين، بما جاء في نصّ زيارته× من قول: «الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي هداني لولايتك، وخصّني بزيارتك»[6].
وفي قولهم الذي حكاه قوله تعالى: (لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ) اعتراف بحقيقة ما وعدهم الله} به على لسان أنبيائه، وهو الذي يأخذون الاعتراف به من أصحاب النار على ما تقصّهُ الآية التي بعدها، وهذا الاعتراف يوم القيامة مأخوذٌ من قبل أصل العظمة والجبروت بالقهر، ويكون ذلك من أهل الجنّة شكراً، ومن أهل النار تماماً للحُجّة[7].
الاقتباس الثاني: التسليم للإمام×
لقد بان انصياع الزائر قسراً لذكر الثناء على مولاه؛ إذ شعرَ بعظمة نعمة هدايته تعالى لولاية مزوره الإمام× والتوفيق لزيارته، وهذا الشعور يجعله يعيش لحظات النعيم، وكأنّه في جنّة الخُلد التي وُعِدَ بها المتّقون. وهذا كُلّه ما كان ليُكتبَ تقديرُه له لولا أن قضى الله تعالى توفيقه إيّاه للإيمان بإمامة سيّد الشهداء×، وأنّه إمامُ هدىً مفترضٌ طاعتُه على كُلِّ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو ما يُقرُّ به الزائر بلسانه وجنانه حينما يُخاطب إمامه× بقوله: «لبيّكَ داعي الله، إن كان لم يُجبكَ بدَنَي فقد أجابكَ قلبي وبشري ورأيي وهواي، على التسليم لخلِف النبي المرسل...»[8].
كما ورد نظيره في مقدّمة إحدى الزيارات عن الإمام الصادق×، وهو قوله: «وقد علمتُ أنّ قِوامَ ديني التسليم لأمرك والاتّباع لسُنّةِ نبيّك»[9].
فطالما أراد المولى سبحانه من دعوة التسليم المطلق للنبي| بعد أداء الدعاء بالصلاة عليه إتماماً لطاعته، وأداءً لحقِّ ولايته على الناس، كما قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)[10]. فأيُّ فخرٍ يناله المسلم أعظم من اشتراكه مع خالقه وملائكته في فعلٍ ينال فيه الطاعة؛ لأنّ أمر المؤمنين بالصلاة عليه| بعد صلاة الخالق وملائكته دلالة على أنّ صلاة المؤمنين هي اتّباع لله تعالى[11].
إنّ المقصود من الصلاة والسلام في الآية المباركة هما على النبي الأكرم| وعلى آله المعصومين^[12]، ويقتضي ذلك توفير جميع متطلّبات السلام، خاصّةً من الناحية النفسية والعملية، فأمان أهل البيت^ وسلامتهم المعنوية هما المقصودان من دلالة الآية المباركة، وهو| الشاهد على أُمّته والمطّلع على أعمالها، فلا بُدّ من مراعاة أوامره واجتناب نواهيه؛ تسليماً لما صدر عنه| من غير اقتراح، ولا أدنى اعتراض، ولا فسحة اختيار سوى التسليم المطلق.
الاقتباس الثالث: الاسترجاع طاعةً وقرباً للمولى
بعد أن استشعر الزائر عظمة هذه النعمة وجلالة قدرها، وحمدَ الله تعالى على هدايته لولايته بامتثال أوامره، والانتهاء عمّا نهى عن فعله حُبّاً لوليّه× الذي ملأَ قلبَه نورُ معرفته، وبعد تذكّر مصابه وما جرى عليه× من دواهٍ عِظام نزلت عليه من أعدائه الذين استحبّوا العمى على الهداية، يسترجع المؤمن حسرةً على تلك الخسارة، موقِناً لقاءه× يوم القيامة والتزوّد من بركاته×؛ ولأجل ذلك ذكر المعصوم× مقطعاً بين نصوص زيارة المولى أبي عبد الله× يحثُّ فيه الزائر على الاسترجاع طاعةً وقُرباً لمولاه؛ حيث ورد في بعض الزيارات ما نصّه: «ثمّ تنكبّ على القبر وتقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، يا مولاي، أنا موالٍ لوليّكم ومعادٍ لعدوّكم»[13].
ونصّ الاسترجاع مقتبس من الآية المباركة: (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)[14]، فقد تضمّنت الزيارة نصّ الاسترجاع إيماناً بقضاء الله وتسليماً لقدره، وهي من الأولويّات العقدية للفرد المسلم، بحسب ما أكّدته النصوص الشرعية.
هذا؛ وقد أثارت الآية الشريفة أعلاه اهتمام المفسّرين؛ لما فيها من آثارٍ معنوية على شخصية المسلم، فالظاهر من معناها أنّها تُشير إلى أنّ المؤمنين قد تسلّوا بالاسترجاع حال مصابهم، وأيقنوا أنّ المُلك لله يتصرّف فيه بحكمةٍ، مع علمهم حفظ الأعمال يوم القيامة، فاكتسبوا صفة العبودية لله (إِنَّا لِلَّهِ)، وأنّهم يرجعون إلى الحساب في معادٍ لا محالة (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ). ولهذا أخبر المولى تعالى عمّا وهبهم، فقال عزّ مَن قائل: (أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ)[15]، أي: ثناءٌ من الله عليهم وأمنَةٌ من العذاب[16].
إذاً؛ الشعور بالعبودية لله تعالى يُعلّمنا ألّا نأسى على مصاب بيأس أو اعتراض؛ لأنّه} هو خالقنا ومالك جميع ما لدينا من نعم، إن شاء منحنا إيّاها باستحقاق، وإن شاء امتحننا بسلبها، وفي المُنحةِ والمحنةِ مصلحةٌ لنا؛ ورسوخ حقيقة رجعتنا إليه يُشعرنا بفناء الحياة، وأنّ منح المواهب غرض زائل، وما هي إلّا وسيلة لتكامل الإنسان.
فاستشعار العبودية والعودة في عبارة (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ). له الأثر الكبير في تعميق روح المقاومة والاستقامة والصبر في النفس، وهذه العبارة لا يكفي ترديدها باللسان فقط، بل لا بدّ من استشعار قلبي بتلك الحقيقة، والتيقّن بما تنطوي عليه من توحيدٍ وإيمان[17].
الاقتباس الرابع: دوام الحالة الإيمانية
ممّا تقدّم يستفيد الزائر من توجيه المعصوم ضرورة العمل طبقاً لمراد العقيدة الحقّة، والطلب الحثيث للثبات عليها بالسؤال تضرُّعاً من الله أن يرزقه دوام الحالة الإيمانية حتى توافيه المنية، وهذا الطلب يترجمه المعصوم بين نصوص الزيارة الجامعة[18] بتضمينه آيةً قرآنيةً من قوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ)[19]. فالزيغ هادم لعمران الهداية وبنائها الإيماني، وهنا ترى المؤمنين صدّروا دعاءهم بربوبيّته تعالى التي هي أفضل وأعلى الغايات، وهو استقامة القلوب على ما يُريده الله تعالى، والثبات على ذلك برجاء ألّا تُمِل قلوبهم بعد توسلّهم بسابق إحسانه وإنعامه.
وأحد أسباب الزيغ هو الابتعاد عن القرآن الكريم وأهله، باتّباع المتشابه وترك المحكم من آياته، «فلمّا كان المتشابه من آي القرآن مزلّة الأقدام، ومدرجة الزائغين إلى الفتنة، وصل الراسخون الإقرار بالإيمان به بالدعاء بالحفظ من الزيغ بعد الهداية، فإنّهم لرسوخهم في العلم يعرفون ضعف البشر وكونهم عرضةً للتّقلّب والنسيان والذهول... فيخافون أن يستزلّوا فيقعوا في الخطأ، والخطأُ في هذا المقام قرين الخطر، وليس للإنسان بعد بذل جهده في إحكام العلم في مسائل الاعتقاد، وإحكام العمل بحسن الاهتداء، إلّا اللّجأ إلى الله تعالى بأن يحفظه من الزيغ العارض، ويهبه الثبات على معرفة الحقيقة، والاستقامة على الطريقة، فالرحمة في هذا المقام هي الثبات والاستقامة»[20].
إنّ الهداية الحقيقية هي اتّباع ولاية شركاء القرآن الكريم وعدله، فهم بمنزلة الآيات المحكمة من القرآن الكريم، في مقابل ولاية أدعياء الخلافة، الذين هم بمنزلة ما تشابه من آياته المباركة، وقد ورد هذا الأمر في الزيارة: «السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا حُجّة الخصام»[21]؛ ولهذا يدعو الزائر بتضرّعٍ ألّا يُحرم من نعمة الهداية لولاية الإمام الحسين×، بل يطلب الاستزادة من حبّه وولائه حتى يجدَ نوره يوم القيامة، فيهديه إلى نعيم الجنّة مع الذين أنعم الله تعالى عليهم من النبيّين والصالحين وحسن أُولئك رفيقاً.
بعد آيات الثناء والتسليم تحتشد نصوص الزيارات الحسينية بصنف مبارك آخر من آيات الكتاب العزيز، وهذا الصنف يحمل بين جنباته معاني عقيدية مهمّة من أُصول الدين، فتذكر التوحيد وصفات البارئ تارةً، مع أصلي النبوّة والإمامة وشروطهما تارةً أُخرى، وهو ما ينبغي سرده بإمعان في الفقرة التالية.
المبحث الثاني: آيات معرفة التوحيد والولاء
الاقتباس الأوّل: مواضع ذكر الله تعالى وتسبيحه
إنّ ركن قصد الزائر لحضرة الإمام الحسين× هو توحيد الله وطلب التقرّب منه ورضاه، فلم يشرع بقصد زيارته إلّا بعد أن استعلم من كتاب الله العزيز ما يدفعه لتحصيل مقدّمات قصده، فقد سَمِعَ اقتباس المعصوم لآية من القرآن في زيارة الجامعة وهو يقول: «فجعلكم في بيوت أذِن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمُهُ»[22]، وهو ما جاء ذكره في قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ)[23]، والبيوت هي المساجد.
وفي بعض الأخبار: إنّها كلّ بيت أو بناء يُذكر فيه اسم الله بالتوحيد والتكبير وإن قيّدتها قرينة (رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ...)بالمسجد[24].
هذا؛ والمؤمنون لا ينحصر ذكرهم لله تعالى في المساجد وإن تأكّد ذكرهم فيها وكثُر.
إنّ صفة هذه البيوت التي يُذكر فيها اسم الله تعالى هي كثرة التسبيح فيها ودوامه، وهذا ما استأنفته الآية في قوله تعالى: (يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ). والتسبيح بالغدوّ والآصال كناية عن استمرار الذاكرين في التسبيح، لا أنّ التسبيح مقتصرٌ في الوقتين فقط، وهو يعني خلوص المعرفة إلى نفي النقائص عنه تعالى وتنزيهه عمّا لا يليق به، فإذا تمَّ التسبيح لم يبقَ معه غيره، وكلّما تمَّ التسبيح تمّت المعرفة به تعالى، ووقع الثناء عليه والحمد له بالتوصيف بصفات الكمال موقعه بعد حصول المعرفة التامّة[25].
يظهر من تتبُّع آراء العلماء في هذه المسألة اتّفاق
علماء المذاهب الإسلامية كافّة عدا
الوهابية من السلفية على رجحان البناء حول قبور الأولياء والصالحين؛ إحياءً لشعائر
الله تعالى وإدامةً لذكره، والتذكير بتأريخ قادة الإسلام وعظماء المسلمين[26]،
وخير شاهدٍ حيٍّ يعيشه المسلمون هو زيارتهم لمشهد بناء مرقد النبي الأكرم| في
المدينة المنوّرة، ومدى اعتناء المسلمين على طول تأريخهم بإقامة هذا الصرح
وإعماره.
الاقتباس الثاني: النزول في المنزل المبارك
لقد مهّد هذا الاعتقاد برجحان الذكر والتسبيح في مرقد الإمام الحسين× للإذن الإلهي برفع منزلة تلك المقامات النورانية ونظائرها بذكر الزائر لمولاه تعالى، ممّا غرس في نفس الزائر دافع الكينونة في حضرة الإمام القدُسية؛ لكي ينالَ بركاتها ويستلهم الدروس والعِبَرَ منها، وراجياً من الله تعالى التوفيق الدائم بالاحتباء من تلك الآثار المعنوية، مُستفتِحاً وروده الحرم باقتباس قرآنيٍّ آخر[27]، ومن الآية القرآنية المباركة: (وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ)[28]، وهي الآية التي ذكرت نجاة النبي نوح× ومَن معه من الطوفان العظيم، وقد أمرهم المولى تعالى بهذا الدعاء عند استقرارهم على سفينة النجاة وتمكنّهم على عدوهم، «وقد ألهمه الله بالوحي أن يحمد ربّه على ما سهّلَ له من سبيل النجاة [الهداية]، وأن يسأله نزولاً في منزلٍ مباركٍ عَقِبَ ذلك الترّحُل، والدعاء بذلك يتضمّنُ سؤال سلامة من غرق السفينة [هلاكاً وضلالاً]»[29].
اذاً؛ الزائر يعتبر نفسه راكباً لسفينة النجاة والهداية وهو يدخل ضريحاً مهدّداً بقوارير السعادة والفوز بالجنان، والنجاة من نيران الضلالة والغواية.
الاقتباس الثالث: الشهادة على التوحيد
إذاً؛ سيدخل الزائرُ الحرمَ الطاهر مطمئناً بسلامة دينه، ومجاهراً بشعار التوحيد، صادحاً لسانه بشهادة الوحدانية، كما ورد في زيارة الجامعة ما نصّه: «أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، كما شهد الله لنفسه، وشهدت له ملائكته، وأُولو العلم من خلقه»[30]، فيقتبسُ مضمونَ تلك الشهادة من آياتِ الذكر الحكيم؛ حيث قال تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[31].
والمقصود من هذه الآية المباركة توجيه الخطاب لكلّ عاقل بأنّ وحدانية الله تعالى أمرٌ قد ثبتَ بشهادته، وكما شهد بها جميع المعتبرين من العقلاء. وتُعتبر هذه الشهادة عامل ثبات المؤمنين على الإسلام؛ لأنّ الدين الحقّ عند الله هو الإسلام، فشهادة الله تعالى على توحيده تعني أنّه خلقَ الدلائل عليها. وأمّا شهادة الملائكة وأُولي العلم من عظيم خلقه تدلُّ على إقرارهم بذلك، وقد جُمعتْ شهادتهم مع شهادة الله تعالى بلفظٍ واحد من حيثُ تسلسلها الطولي.
ويبقى أنّ الشاهد الحقيقي هو الله تعالى؛ وذلك لأنّه} هو الذي خلق الأشياء بقدرته، وجعلها دلائل
على توحيده، ولولا تلك الدلائل لما صحّت الشهادة، ثمّ بعد ذلك أظهر تلك الدلائل
بحيثُ وفَّقَ العلماءَ لمعرفتها، ولولا تلك الدلائل التي نصبها سبحانه وتعالى وهدى
الناس إليها، لعجزوا عن التوصّل بها إلى معرفة التوحيد، فلذا كان أصل الشهادة على
الوحدانية هو الله وحده[32]،
كما قال تعالى:
(قُلْ أَيُّ
شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ)[33].
وفي معاني شهادة الله على توحيده ذُكرت وجوه بيانية عدّة، منها ما يلي:
الوجه الأوّل: إنّ شهادة الله عزّ اسمه على أنّه لا إله إلّا هو، تعني أن ليس هناك أحدٌ أو شيءٌ يُغني من قدرته تعالى وسلطانه، من مال أو ولد أو غير ذلك من زينة الحياة، أو أيّ سبب من الأسباب المادّية؛ إذ لو كفى منه تعالى شيءٌ لكان إلهاً من دونه جلّ وعلا، وقد شهد تعالى بهذه الشهادة وهو قائمٌ بالقسط في تدبيره، وحاكمٌ بالعدل في خلقه، إذ دبّر أمر العالم بخلق الأسباب والمسبّبات ونواميسها، حتى جعل الكلّ مستنداً إليه تقدّست أسماؤه بالسير والتكامل، وجعل في مسير الإنسان هبات الهداية؛ لينتفع منها الإنسان في عاجله الفاني لآجله الباقي، وهناك ينال المرء حسابه بالقسط.
فالله تعالى يشهد بذلك، وهو شاهد عدل، وأنّ عدله يشهد على نفسه وعلى وحدته في أُلوهيّته، أي: إنّ عدله تعالى ثابت بنفسه ومثبت لوحدانيّته؛ وعليه نعتبرُ في الشاهد شرط العدالة؛ ليكون ملازماً لصراط الفطرة الإلهية من غير أن يضع الأمر في غير موضعه، فيكون مأموناً عن الكذب والزور، فملازمة الصدق يوجب عدالة الإنسان، ونفس النظام الحاكم في العالم والجاري بين أجزائه الذي هو فعْلُهُ سبحانه هو محض العدل[34].
الوجه الثاني: إنّ هذا التوحيد وإن كان في صورة الشهادة، إلّا أنّه في معنى الإقرار الفطري؛ لأنّه لمـّا ألهم اللهُ تعالى عباده أنّه لا إله سواه، كان الكلُّ مقرّاً له بذلك. والمولى الكريم لا يليق به إلحاق الضرر بعبيده، فكان هذا الكلام جارياً مجرى الإقرار بأنّه يجب عقلاً على الكريم أن يُصلح شؤون خلقه من جميع الجهات[35].
ممّا تقدّم يمكن معرفة الغرض العقدي من الشهادة في اللمسة البيانية للآية المباركة، فهي تُعطي لمـَن يتلوها خلال زيارته دلالةً معرفيةً على التوحيد الإلهي الشامل لصفات الكمال من العدل، والإتقان لشؤون العباد، وحُسن المنقلب في دار الآخرة، وهذا كلّه يُورث المؤمن دواعي الاطمئنان القلبي والاستقرار النفسي، فترى باله يسرح في بحبوحة التوحيد، ويسبح في غمراته الأحدية، موقِناً بقوّة سنده ومعتمده، فيروح ويغدو مسترسلاً بإكمال شهادته العقدية في سلسلتها الطولية، فيذكر حكمة بارئه ولطفه باصطفاء النبي الأكرم|، وما أنزل عليه من معجزة خالدة تُنير للسالكين ما ادلهمّ عليهم من مسائل ومعضلات، فيقول الزائر حينها: «آمنّا بالله وبرسوله وبكتابه، وبما جاء من عند الله، اللّهمّ اكتبنا مع الشاهدين»[36]، وهي تتضمّن معنى الآية المباركة التي اقتبس نصّها في زيارة الجامعة الكبيرة أيضاً من قوله تعالى: (رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ)[37].
إنّها شهادة أُخرى تصدر هذه المرّة من المؤمنين، إذعاناً لشهادة ربّهم عزّ اسمه وملائكته ورسله، وهذا الإقرار مقرونٌ برجاء القبول بتضرّع عند صاحب الشهادة الكبرى، وأمام مَن فدى نفسه في سبيل تطبيق تلك الشهادة عمليّاً على أرض الواقع الإسلامي حتى مضى شهيداً.
فطلب تثبيت الشهادة في سجّل الموحّدين تعني سؤالاً من الله تعالى مفاده: «فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شهدوا بالحقّ، وأقرّوا لك بالتوحيد، وصدّقوا رُسُلك، واتّبعوا أمرك ونهيك، فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيما تُكرمهم به من كرامتك، وأحِلَّنا محلّهم، ولا تجعلنا ممّن كفر بك، وصدَّ عن سبيلك، وخالف أمرك ونهيك»[38].
الاقتباس الرابع: اتّباع الأمر الإلهي
إنّ خير دليل على الإقرار بالتوحيد الإلهي هو اتّباع أمر الله تعالى في موالاة رسله وأوصيائهم، والتبرّي من أعدائهم ومخالفيهم على بصيرةٍ من الأمر، فالأولياء هم الذين أدّوا الأمانة الإلهية على أتمّ وجه، وكأنّهم مسخّرون كالملائكة في تبليغ رسالات الله تعالى نصّاً بلا زيادة ولا نقصان، فيشهد الزائر لإمامه× بتلك الخصيصة في الزيارة الجامعة بقوله: «السلام على عباد الله المكرمين، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون»[39]، وهي صفة ذكرها الله} لملائكته في كتابه المجيد؛ حيث قال تعالى: (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ *لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ)[40].
ومن هنا؛ فالزيارة فيها إشارة إلى عصمة أولياء الله تعالى من الأنبياء والأوصياء في تبليغهم لرسالاته، وهو ما يبعثُ إلى الاطمئنان إليهم^، وأخذ معالم الدين منهم، والسير بحسب نهجهم على الصراط المستقيم.
الاقتباس الخامس: الشهادة على الرسالة المحمدية
إنّ مقام النبوّة هو منصب رسالي يعكس صفة اللطف الإلهي بعباده، ويكون واسطة الفيض الروحي بين الخالق وعباده، وهذا الفيض يحمل نسمات الهداية والكمال حين تضعف الفطرة السليمة، ممّا يحدو بالزائر إلى الإقرار بضرورة هذا الأصل العقدي في زيارته لوصي النبي الأكرم|، فيردّد شهادةً تؤكّد سلامة فطرته، مقتبساً كلمات شهادته لصفة النبوّة من آي الذكر الحكيم حين يقول في أحد مقاطع الزيارة الجامعة: «وأشهد أنّ محمداً عبده المنتجب، ورسوله المرتضى، أرسله بالهدى ودين الحقّ، ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون»[41]. وهي شهادةٌ تضمنتْ نصّ الآية المباركة من قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)[42]، حيثُ إنّ مراد الله} هو الهداية لطريق الحقّ، وأنّ ذاته تقدّست أسماؤه هي نور السماوات والأرض، فلا بدّ للهداية من استعداد وأرضية مناسبة في النفس الإنسانية كي تؤثّر فيها، وهذا ما لا يحصل بالنسبة إلى الأشخاص الذين يجانبون الحقّ ويعرضون عن الحقيقة ويعادونها، فإنّ هؤلاء هم أظلم الناس؛ لأنّهم يصدّون أنفسهم عن طريق الحقّ والهداية والنجاة، ويصدّون سائر عباد الله عن منابع الفيض الإلهي، ويحرمونهم من السعادة الأبدية.
ومن هنا، فالآية الكريمة بصدد التأكيد على حقيقة أنّ الهداية والضلالة بالرغم من أنّهما من الله تعالى، إلّا أنّ مقدّماتهما ومنطلقاتهما من الإنسان نفسه بلا جبر، والجهود والمؤامرات الشيطانية ضدّ نبي الإسلام غير قادرة على إطفاء شعلة الوهج الرسالي الذي أتى به النبي محمد|، وبذلك تحقّق التنبؤ القرآني في الفشل الذريع الذي لحق بهؤلاء الذين أرادوا كيداً بالرسالة الإلهية، بل إنّ النور الإلهي في حالة انتشار، كما تكشف ذلك لنا الإحصائيات؛ حيث إنّ عدد مسلمي العالم في تزايد مستمرّ بالرغم من الجهود المتظافرة من الصهاينة والصليبين في بذل أقصى الجهود لإطفاء نور الله تعالى، ولكنّ لإرادة الله شأناً غير ذلك. وهذا الأمر بحدّ ذاته يُثبت الإعجاز القرآني وعظمة الإسلام[43].
الاقتباس السادس: اتّباع نور أهل البيت^ والفوز معهم
وهذا النور العظيم يدعو كلّ ذي فطرةٍ أن يقتبس منه ما يُنير به دربه في ظلمات الأرض، فيدعو الزائر ربّه تضرّعاً في زيارته قائلاً: «اللّهمّ اجعلنا ممّن يتّبع النور الذي أُنزل معهم»[44]، وقد تضمّن هذا الدعاء جزءاً من قوله تعالى: (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)[45].
واتّباع النور هو مجاز للاقتداء بتعاليم القرآن الكريم، فالساري في الليل إذا لاحَ له نور اتّبعه؛ لعلمه بمنافعه في المسير. والنور يصلح مستعاراً للقرآن الكريم؛ لأنّ الشيء الذي يدلُّ على الحقّ والرشد يُشبّه بالنور. والإشارة في قوله تعالى: (أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) للتنويه بعلوّ شأنهم، واستحقاقهم للثناء، وكونهم ممّن ساروا على درب الهداية، كما في قوله تعالى: (أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ...)[46].
وفي الآية المتقدّمة تنويه بعظيم فضل أتباع النبي الأكرم|، ويُلحَق بهم مَن نصر دين الإسلام من بعدهم[47].
إنّ ذلك النور الإلهي الذي صدر من الذات المقدّسة، وتجلّى في حضرة النبي الأكرم|، قد استمرّ بعد شهادته| في أوصيائه من أهل بيته وعترته، ومنهم الإمام الحسين× الذي كان منه|، وعلّة جريان ذرّيته الطاهرة من ولده، فصار دوام حمل الرسالة وتجلّي النور من نسله×؛ ومن هنا نرى في الزيارة الشعبانية الحثّ على تأكيد هذه الحقيقة: «أشهد أنّك نور الله الذي لم يُطفأ ولا يُطفأُ أبداً، وأنّك وجه الله الذي لم يهلك ولا يهلك أبداً»[48].
ونتيجة هذا النور نجد أنّ خالص دعاء الزائر هو الكينونة في حضرة هذا الإمام والحظوة في أن يُكتب من شيعته وأوليائه الصالحين؛ حيث يرجو في زيارته ما يتلوه برقّة وأدب: (يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا)[49]، وهذا الرجاء والتمنّي قد ورد في الذكر الحكيم في قوله تعالى: (وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا)[50]. وورود هذا التمنّي وإن كان على لسان المنافقين حسداً للمؤمنين[51]، لكنّه هنا يرد على لسان المؤمن باستعمال خاصٍّ من المعصوم وعناية منه، ليُعطي معنى الغبطة لمقام الشهداء في جنّات النعيم.
الاقتباس السابع: الشهادة على عصمة أهل البيت^
يتواصل الزائر في تقديم ولائه للإمام منطلقاً من معرفته بنقاط الاشتراك في صفاته× مع صفات جدّه النبي الأكرم|، ومستلهماً معاني المعرفة لأئمّته من القرآن الكريم حين يصفهم بالقداسة والعصمة بشهادته في الزيارة الجامعة: «وطهّركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس وطهّركم تطهيراً»[52]. وفي زيارةٍ أُخرى يقول: «وجعلك من أهل البيت الذين أذهب عنهم الرجس...» [53]. وهذه الشهادة العظمى التي تجري على لسان الزائر هي اقتباس من كتاب الله المجيد، واعتراف منه بجلالة قدر أئمّة الهدى، وضرورة اتّباعهم والتفاني في تبليغ رسالتهم وتعاليمهم، وهو ما أرشد المولى تعالى في بيان عصمتهم من قوله تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)[54].
إنّ الملاحظ من صيغة الآية المباركة (إِنَّمَا يُرِيدُ) هو نوع الإرادة الإلهية هنا، فالإرادة في منطوقها حتمية التنفيذ والوقوع، وأنّ إرادة الله تعالى قد ختمت بأن يكون أهل البيت^ معصومين عن كلّ رجس وخطأ.
وثمّة مسألة تستحقّ الانتباه، وهي أنّ المراد من الإرادة الإلهية هنا هي نوع من الإمداد الإلهي الذي يسدّد أهل البيت^ على العصمة بالاستمرار فيها، وهي في الوقت نفسه لا تنافي حرّية الإرادة والاختيار، ولا تقتصر العصمة على تنفيذ الأوامر والأحكام الإلهية في مسائل الحلال والحرام؛ لأنّها تشمل الجميع[55].
إنّهم^ صناعة إلهية خاصّة جُعلت مناراً لسائر العباد بلطف الله تعالى وحُسن رعايته لعباده، فمن أحبّهم فقد وصل بحبّه إلى الله تعالى، ومن ثمَّ أحبّ الله في عرشه، ومَن زارهم^ فكأنّما قصد الله} في زيارته وعرج بروحه إلى عرشه، ويشهد المعصوم× في نصّ الزيارة الجامعة بذلك حين يقول: «ومَن أحبّكم فقد أحبّ الله»[56]، ومن أحبَّ الله تعالى عمل بشريعته وامتثل أوامره، كما قال تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[57].
الاقتباس الثامن: شهداء الطفّ ربّيّون وأنصار الله
إذاً؛ خير دليل على صدق محبّة الله تعالى هو الطاعة المطلقة لأنبيائه وأوصيائهم^ الذين اجتباهم الله بحكمته، ومَن يتّبع الأوصياء من ذرّية النبي كان من حزب الله وجُنده، وكان متّبعاً لربّه ومولاه}، ومن الربّانيّين بتوحيده لطاعة الله تعالى؛ وعليه نسمع المعصوم× يشهد لهؤلاء الشهداء ممّن حلّت روحه بفناء الإمام الحسين تضحيةً له وفداءً بصفة الربّانيّين، كما ورد في الزيارة من شهادة بقوله×: «أشهد أنّك قاتل معك ربّيّون كثير، كما قال تعالى: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ)[58]»[59].
ويشهد لهم أيضاً في زيارة الشهداء بقوله×: «أشهد أنّكم أنصار الله كما قال الله}: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا)»[60]، حيثُ جاءت هذه الآية على هذا النظم البديع الصالح لحمل الكلام على تثبيت المسلمين في حال المصاعب وزلزلة القلوب بتهديد النبي|.
والربّيّون جمع ربّي، وهو المتّبع لشريعة الربّ، مثل الرجل الربّاني، والمراد بهم هنا أتباع الرسل وأوصياء الأنبياء، ومحلّ الشاهد هنا هو ثبات الربّانيّين على الدين مع موت أنبيائهم وأئمّتهم. وقوله: (فَمَا وَهَنُوا)أي: لم يضعف الربّيّون؛ إذ من المعلوم أنّ الأنبياء لا يهنون، فالقدوة المقصودة هنا هي أتباع الأنبياء، والأجدر بالعزم هو أتباع النبي محمد| ومَن سار على نهجه[61].
الاقتباس التاسع: الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة
قد تكون أهمُّ صفة تحلّت بها الحركة الحسينية المباركة هي صفة المطابقة مع مقتضيات المصلحة الإلهية، وهو ما يهوّن وقع ذلك الخطب الجلل على قلوب المؤمنين، فقد كانت تلك النهضة المعطاء في منتهى الحكمة حين وضع الإمام الحسين× كلّ فرد في موقعه المناسب بالرغم من كثرة الاعتراضات التي صدرت من المقرّبين بعد قراره× في حمل النسوة معه إلى كربلاء، فهنا جاء وصف المعصوم× لحركته المباركة بالدعوة الحكيمة، كما ورد في نصّ الزيارة الجامعة قوله×: «ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة»[62].
وتكرّر هذا المعنى أيضاً في زيارة مخصوصة له× قال فيها الإمام الصادق×: «وجاهدت في سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة»[63]. كما ورد كذلك في زيارته ليلتي عيدي الفطر والأضحى: «وأشهد أنّك التالي لكتاب الله، وأمين الله الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة»[64].
فقد تضمّنت هذه الزيارة معنىً قرآنياً طالما استعمله المولى تعالى في كتابه المجيد في قوله تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)[65]. ويُستفاد من الآية أنّ هذه الأُمور الثلاثة: (الحكمة، والموعظة، والمجادلة) من طرق التكليم والمفاوضة؛ فقد أمر الله تعالى بالدعوة بأحد هذه الأُمور، فهي من أنحاء الدعوة وطرقها.
وقد فُسّرت الحكمةُ بمطابقة الحقّ يقيناً وفق العقل، والموعظة هي التذكير بالخير فيما يرقُّ له القلب، ومعنى الجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. فالمراد بالحكمة هو الحجّة التي تُنتج الحقّ الساطع، والموعظة هي البيان الذي تلين به النفس ويرقُّ له القلب؛ لما فيه من صلاح حال السامع رجاء هدايته للصواب، والجدال هو الحجّة التي تُستعمل لثني الخصم عما يصرُّ عليه من باطل، وينازع فيه من غير حُجّة[66].
الاقتباس العاشر: إتيان اليقين بعد التضحية في سبيل الدين
ممّا تقدّم يستبين للمتأمّل مدى حكمة الإمام الحسين× في دعوته الكبرى، مع ما أحاطت به من ظروف صعاب لا يُطيقها إلّا مَن ألهمه الله} الصبر والحكمة بالتأييد الدائم حتى بلوغ درجة الشهداء، والكينونة مع السعداء من النبيّين وحسن أُولئك رفيقاً، وهو ما شهد به المعصوم وأمرنا بتلاوة هذا النصّ خلال زيارتنا لمشهد سيّد الشهداء بقوله×: «وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين»[67].
فلم يجد× بُدّاً ولا جدوى من الحوار مع قوم ختم الله على قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشدّ قساوةً، فلم تمل لهداية وصي النبي الكريم وسبطه، مع ما بالغ× في دعوتهم للحقّ، فما كان منه× إلّا أن يُثبت حقّه وصواب موقفه بدمه الطاهر؛ ليكون شاهداً عليهم يوم القيامة وحجة بالغة تدحض معذرتهم، وكان جهاد الإمام الحسين× مصداقاً لطاعة الله تعالى حين قال: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)[68].
وليس المراد باليقين هنا المعرفة والكشف، وأنّه متى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف، وهو قول كفر وضلال وجهل؛ لأنّ الأنبياء× كانوا هم وأوصياؤهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته، وما يستحقّ من التعظيم، وكانوا مع هذا أكثر الناس طاعة، وأكثرهم عبادة ومواظبة على فعل الخيرات حتى الوفاة. وإنّما المراد باليقين هاهنا الموت والتضحية في سبيل الدين[69].
لقد وفى الإمام الحسين× وجاد بنفسه القُدسية امتثالاً لأمر بارئه}، فكانت تضحيته مثلاً للثائرين الربّانيّين، الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم.
وممّا ميّز هذه النهضة اندلاعها بوجه مَن اتّخذ من
الإسلام رداءً يتستّر به في إجرامه
وفتكه، وفضح حقيقتهم بكشف أعمالهم الباطلة وأفعالهم الفاسدة، فامتازت الإمامة إلى
جهتين متضادّتين لا تلتقي خطوطهما في الدنيا والآخرة، فإمامة باطلة تقود الناس إلى
النار وبئس المصير وإن كانت باسم الخلافة والإسلام، وإمامة حقّة تقود الناس إلى
الجنّة والسعادة الأبدية.
المبحث الثالث: آيات المعرفة بيوم الجزاء
الإيمان بيوم المعاد هو ثالث أُصول العقيدة عند المسلمين عامّة، وفيه ترجمة واقعية للحوادث التي جرت في هذه الدنيا، فكلُّ إنسان مصيره مرهون بعمله وعقيدته، وينال جزاءه بحسب سلوكه وعطائه، فلا يضيع حينها أجر العاملين، ولا يفوت وقتها ظالم من العقاب الأليم. ثُمّ إنّ الاعتقاد بالمعاد يُخرج حياة الإنسان من طور العبثية ويُبعد إحساسه باللغوِ، وإنّ لحياته غايةً مُحكَمةً لا يضيع فيها أجر العاملين، ويُنتصَفُ بعدها في الآخرة للمظلومين من الظالمين إن لم يأخذ المظلوم حقّه في الدنيا، فقد ذكر المولى تعالى في محكم كتابه: (َمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ)[70].
الاقتباس الأُوّل: البراءة من أئمّة الكفر
وهذه الحقيقة المهمّة التي هي أحد أركان الإيمان لدى الزائر جعلته يلتفت إلى مطلب مهمّ يستثمر فيه زيارته بضمان خاتمة سعيدة تورثه جنّة النعيم، ويبرأ من كلّ سبب يبعده عن طموحه وأمله كي لا يرديه في الحاطمة، فيقول في دعاء الزيارة الجامعة: «ومن ردّ عليكم في أسفل درك من الجحيم... وبرئت إلى الله من أعدائكم، ومن الجبت والطاغوت والشياطين، وحزبهم الظالمين لكم... ومن الأئمّة الذين يدعون إلى النار»[71].
فهؤلاء الذين يتبرّأ منهم المؤمن هم أئمّة الكفر والظلم ممّن ذكرهم الله تعالى في كتابه، وجعلهم أسباباً لورود جهنّم، حيث قال تعالى: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ)[72]، حيث جعل الله تعالى أئمّة الكفر والطغاة يأتمّ بهم أهل العتو والغي، فيدعون الناس إلى القيام بأعمال أهل النار من ظلم؛ طاعةً للشيطان (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ)، أي: ويوم القيامة لا ينصرهم أحد من هؤلاء إذا عذّبهم الله تعالى، وقد كانوا في الدنيا حلفاً يتناصرون، فاضمحلّت اليوم تلك النصرة[73].
كما يشكر المؤمن ربّه أن هداه لصراطه المستقيم بولائه لأئمّة الحقّ الميامين، فيقول في الزيارة نفسها: «وبكم أخرجَنا اللهُ من الذلّ، وفرّج عنّا غمرات الكروب، وأنقذنا من شفا جرف الهلكات ومن النار»[74].
الاقتباس الثاني: الدعاء بالمغفرة
ويبدأ المؤمن بالدعاء في زيارته بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين في ذلك اليوم المهول، فيسترسل خاشعاً في دعائه ومعلِّقاً أمله بالجواب، قائلاً: «اللهمّ اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربّياني صغيراً... اللهمّ اجزهما بالإحسان أحساناً»[75]، حيث يشتمل قلب المؤمن على روح الرحمة والوفاء لوالديه اللذين ربّياه بعناء حتى بلغ وصار رجلاً، وقد اقتبس هذا المعنى من قوله عزّ من قائل: (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ)[76].
هذه الدعوة العظيمة من الدعوات الجليلة قدراً، التي دعا بها خليل الرحمن ونبي الله إبراهيم×، وفيها أعظم المطالب والمقاصد التي يرجوها المؤمن في الدار الآخرة، فهو× طلب المغفرة له ولجميع المؤمنين، وهذا الطلب يدلّ دلالةً جليلةً على ما أُوتي× من الشفقة على جميع المؤمنين.
هذا؛ وقد كان النبي إبراهيم× متّجهاً دائماً إلى مقام الربوبية فنادى ربّه بها، وما فيها من ضراعة المؤمن المقدِّر لنعمة الإيجاد والربوبية، والقيام على شؤونه، وأنّه الحيُّ القيّوم القائم على ما أنشأ من خلق، وهو اللطيف الخبير، ودعاه بالمغفرة، وابتدأ بنفسه أوّلاً، ثمّ ثنّى بوالديه، وثلّث بالمؤمنين الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، سواء أكانوا من ذرّيته، أم كانوا من غيرهم، فهو دعاء لعامّة المؤمنين، والخليل× كانت أدعيته العامّة جماعيةً؛ لأنّه نادى بالأُخوّة الإنسانية[77].
الاقتباس الثالث: الشفاعة لمن ارتضاه الله تعالى
ثُمّ يشهد الزائر لإمامه وسائر الشهداء بالبقاء في دار الخلود سعداء حين يُخاطبه: «أشهد أنّكم أحياء عند ربّكم تُرزقون»[78]، وهو تضمّن لمعنى الآية المباركة: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)[79].
وممّا ذكره المفسّرون حول أسباب نزول هذه الآية المباركة وشأنها أنّها نزلت بعد معركة أُحد، وقد روى ابن مسعود عن النبي الأكرم| أنّه قال: «أطلع إليهم [أي أرواح شهداء أُحد وهي في الجنّة] ربّهم إطلاعةً فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أيّ شيءٍ نشتهي ونحن نسرح من الجنّة حيث شئنا! ففعل تعالى ذلك بهم ثلاث مرّات، فلّما رأوا أنّهم لم يُتركوا من أن يُسألوا قالوا: يا ربّ، نُريد أن تردّ أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتل في سبيلك مرّةً أُخرى. فقال تعالى: قد سبق منّي أنّهم لا يرجعون. قالوا: فتُقرئ نبيّنا عنّا السلام وتبلّغهم ما نحن فيه من كرامة فلا يحزنوا، فنزلت هذه الآيات»[80].
إنّ الخلود طموح كلّ إنسان عاقل يرغب بثبات سعادته وديمومتها، والإنسان مسؤول عن أعماله وسائر تصرّفاته وسلوكه في هذه الحياة الدنيا، وعلى أثرها يكون خالداً في جنّة النعيم إن كان ممّن أطاع مالك يوم الدين وشايع أولياءه؛ فالمرء مقرون بمَن يقتدي ويُحشر مع إمامه وقائده الذي امتثل أوامره، ويحاول معالجة تقصيره وتكفير بعض ذنوبه بطلب شفاعة مَن والاه في دنياه وعمل في مودّته، فيردّد خلال زيارته لإمامه المعصوم دعاءً بإلحاح وإصرار على القبول في مواطن يُحبّ الله تعالى مَن دعاه فيها، فيقول ملتمساً: «إليك يا ربِّ صمدت من أرضي، وإلى قبر ابن نبيّك قطعت البلاد رجاءً للمغفرة، فكن لي يا سيّدي سَكَناً وشفيعاً... وكن لي منجاً يوم لا تنفع الشفاعة عنده إلّا لمـَن ارتضى، يوم لا تنفع شفاعة الشافعين، ويوم يقول أهل الضلالة: ما لنا من شافعين ولا صديق حميم...»[81].
وفي هذا المقطع الشريف اقتباسات عدّة قد تضمنّت عدداً من الآيات القرآنية المباركة، منها قوله تعالى: (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ)[82]، وقوله المبارك: (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى) فيه تعريض لشفاعة الأوثان وإنكار لاعتقاد الوثنية في عبادتهم الملائكة، كما يُنبئ عنه قولهم الذي حكاه عنهم قوله تعالى: (هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ)[83]. وما ورد كذلك في قوله تعالى: (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى)[84]، فجاءهم الردّ بأنّ الملائكة إنّما يشفعون لمـَن ارتضاه الله تعالى، والمراد بذلك ارتضاء دينه لقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)[85]،فالإيمان بالله تعالى من غير شركٍ هو الارتضاء المقصود بالآية كما دلّت عليه الروايات، والوثنيون مشركون، فلا يُشفع إلّا للموحّدين.
وقوله: (وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ)، يعني خشية الملائكة من سخطه وعذابه يوم القيامة مع الأمن منه بسبب عدم المعصية؛ وذلك لأنّ جعله تعالى إيّاهم في أمن من العذاب بما أفاض عليهم من العصمة، لا يُحدّد قدرته تعالى، فهو يملك بعد الأمن عين ما كان يملكه قبله، وهو على كلّ شيءٍ قدير[86].
ثمّ يتمّ تفصيله عن نفع الشفاعة للمؤمنين المقصّرين دون المشركين غداً يوم الدين والجزاء بقوله تعالى: (فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ)[87]، فالمسلم الذي قصّر في واجباته وأضاع بعضها كان مستحقّاً للعذاب في سقر على مقدار إضاعته، وعلى ما أراد الله تعالى من معادلة حسناته وسيّئاته، وظواهره وسرائره، لكنّه} عندما حرم المجرمين من الكافرين من أن تنفعهم الشفاعة، فعسى أن تنفع الشفاعة المؤمنين على أقدارهم؛ وعليه فالمقطع المتقدّم من الآية فيه إيماء إلى ثبوت الشفاعة لغير الكافرين يوم القيامة جملةً، وتفصيلها كما جاء في صحيح الأخبار[88].
إذاً؛ تثبتُ الشفاعة بحقّ العاصين من المسلمين فقط دون الكافرين على رأي علماء المدرستين كما تقدّم.
نعم، بقي مَن له حقّ الشفاعة للمؤمنين، هل ينحصر ذلك بالملائكة فقط؟ أو أنّه يشمل الأنبياء وأوصياءهم وسائر الأولياء؟
لقد دلّت الأخبار المعتبرة على شمول الرضا لجميع الأنبياء وأوصيائهم ومَن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ولا يسع المقال لتفصيل أكثر.
الاقتباس الرابع: الدعاء على أعداء أهل البيت×
بعد طلب الزائر للشفاعة وإخلاصه بالدعاء للكون من شيعته ومواليه، ينتقل من جنبة الولاء لإمامه× إلى جنبة البراء من أعدائه×، ويُعلن ذلك بالدعاء لمولاه} أن يحلَّ العذاب بمَن حارب إمامه الحسين× وتسبّب بقتله، فاللعن ورد في تراث الإسلام كنتيجة طبيعية لكلّ مخالفة شرعية يتقدّمها الإقدام على قتل النفس المحترمة، فكيف بإزهاق نفوس الأنبياء وأبنائهم وأوصيائهم؟!
لقد جاء في النصوص الخاصّة بزيارة الإمام الحسين× موارد كثيرة تدعو على الأعداء باللعن والطرد من رحمته تعالى، والتبرّي منهم ومن أفعالهم وأشياعهم، ومنها ما قاله المعصوم في زيارته×: «اللهمّ العن الذين بدلّوا نعمتك كفراً»[89]. وفي زيارة أُخرى وهي زيارته× ليلة القدر المباركة ورد قوله×: «أشهد أنّ الذين خالفوك وحاربوك، والذين خذلوك، والذين قاتلوك، ملعونون على لسان النبي الأُمّي، وقد خاب مَن افترى»[90].
فالذين حاربوا الإمام الحسين× هم من الذين بدلّوا نعمة
الله تعالى، وهي الولاء لأئمّة الحقّ بالكفر والضلال، فكانوا من الذين استحقّوا
العذاب كما
قال تعالى: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا
وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ
الْقَرَارُ)[91]، وكان سبب الطرد من الرحمة هو جعل هؤلاء
الذين بدّلوا نعمة الله كفراً لربّهم أنداداً يعبدونهم ويرون لهم حقّ الطاعة، وهو
المراد من أنّهم جعلوا لله شركاء، فقضى}
أن يتمتّعوا في الحياة الدنيا؛ فإنّها فانية وسريعة الزوال، ثُمَّ إلى النار
يصيرون عن قريب، فتعلمون هنالك مغبّة تمتّعكم في الدنيا بمعصيتكم الله وقتالكم
لأوليائه[92].
إنّ هذا اللعن قد ورد بإيحاء الله تعالى وعلى لسان أنبيائه^ كما قال تعالى: (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ)[93].
إنّ المشيئة الإلهية قد جعلت لكلّ أمر سبباً، واللعن (الطرد) أمر خطير مخالف لمبدأ الرحمة الإلهية بعباده، فما هو سببه يا تُرى؟
الجواب هو: «أنّ بني إسرائيل كانوا قد ثاروا على داود مع ابنه ابشلوم. وكذلك لَعْنُهم على لسان عيسى متكرّر في الأناجيل... والجملة مستأنفة استئنافاً بيانياً؛ كأنّ سائلاً يسأل عن موجِب هذا اللّعن، فأُجيب بأنّه بسبب عصيانهم وعدوانهم، أي لم يكن بلا سبب»[94].
وهكذا سرت سُنّة اللعن في أُمّة الإسلام من المنافقين كما أخبر النبي الأكرم| بمشاكلة المسلمين لليهود بأفعالهم ومعاصيهم حذوة القذّة بالقذّة، فكما قتَل بني إسرائيل أنبياءهم وأوصياءهم عمد المسلمون إلى نفس أفعالهم في قتْل ذرّية نبيّهم، فقتلوا الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه في كربلاء، ولم يكن قتْلهم عن ذنب سوى أنّهم^ حاولوا الإصلاح في أُمّة الإسلام بعد فساد أحوالها في زمن بني أُمية، فكان أُولئك القتلة من المستحقّين لعذاب الله تعالى ولعنته. ولفداحة المصيبة يجد الزائر أنّ الدعاء بذلك له مبرّره، فاقتضى الإلحاح في رجائه من المولى تعالى، فيسترسل داعياً بقوله: «لتخلّدَهم في محطٍّ ووِثاق ونار... وفي سقر التي لا تبقي ولا تذر»[95].
ويحدوه الأمل أن يشفي صدره بالانتقام من أعدائه غداً يوم القيامة، بعد أن حبس النصر عن وليّه في الدنيا، وتأخّرت عقوبتهم جزاء جريمتهم الكبرى بحقّ الإسلام والإنسانية جمعاء، فيواصل المؤمن دعاءه بحقّ هؤلاء العصاة ويقول: «ويريني أعداءكم في أسفل دركٍ من الجحيم»[96].
وبهذا المنظر يتحقّق في نفس المؤمن ما يشفي صدره من الغليل، ويبرّده من تلك الجمرة التي أحرقت فؤاده في الدنيا لهول ذلك المصاب الجلل، ويقول حينها: الحمد لله ربِّ العالمين.
الخاتمة
إنّ الغاية من الاستعمال القرآني نصّاً ومضموناً في الزيارة الحسينية هي تربية المؤمن عقائدياً، فيستلهم منها الدروس للتسليم بأمر الله وقضائه، ويتعرّف أكثر على صفات خالقه الذاتية والكمالية من توحيد، ومعارف الانقياد والتولّي لأولياء الله، والبراءة من أعدائه.
فالإيمان بالله تعالى لا بدّ أن يكون خالصاً لا يشوبه أيُّ طاعة لأعداء الله تعالى، وعلى المؤمن أن يلتزم نصرة أولياء الله تعالى ويتبرّأ من أعدائه في الدنيا والآخرة، فيدعو لأوليائه} وينصرهم، ويلعن أعداءه من الأوّلين والآخرين، ومَن سايرهم وشايعهم إلى يوم الدين.
والحمد لله ربِّ العالمين وصلّى الله على محمدٍ وآله الطيبين الطاهرين.
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1.- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، مطبعة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1403هـ.
2.- تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي القرشي (ت774 هـ)، تقديم: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.
3.- تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم)، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا علي خليفة القلموني الحسيني (ت1354هـ)، الناشر: الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 1990م.
4.- تفسير مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الفخر الرازي (ت604هـ)، نشر: دار الفكر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1981م.
5.- جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (ت310هـ)، المحقّق: أحمد محمد شاكر، مؤسّسة الرسالة، الطبعة الأُولى، 1420هـ/2000م.
6.- روضة المتّقين في شرح مَن لا يحضره الفقيه، محمد تقي المجلسي (ت1070هـ)، مؤسّسة كوشانبور للطباعة والنشر، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1406هـ.
7.- زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، طبعة القاهرة بعشرة أجزاء.
8.- ضياء الصالحين، الشيخ محمد صالح الجوهرجي، مكتبة الألفين للطباعة، الكويت، الطبعة الأُولى، 1405هـ.
9.- عمدة الزائر في الأدعية والزيارات، آية الله السيّد حيدر الحسني الكاظمي، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة، 1979م.
10.- كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمّي (ت368هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيّومي، مؤسّسة نشر الفقاهة، مؤسّسة النشر الإسلامي للطباعة، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
11.- مفاتيح الجنان (ويليه الباقيات الصالحات)، الشيخ عبّاس القمّي (ت1359هـ)، تعريب: السيّد محمد رضا النوري النجفي، نشر: مكتبة العزيزي، قم ـ إيران، الطبعة الثالثة، 1385هـ.ش/2006م.
12.- الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، عدد الأجزاء: 45 جزءاً، الطبعة (من1404هـ 1427هـ). الأجزاء 1 ـ23: الطبعة الثانية، دار السلاسل، الكويت. الأجزاء 24 38: الطبعة الأُولى، مطابع دار الصفوة، مصر. الأجزاء 39 45: الطبعة الثانية، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
13.- الميزان في تفسير القرآن، السيّد محمد حسين الطباطبائي (ت1402هـ)، طبعة محقّقة من قبل المؤلِّف، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية في قم المقدّسة، قم ـ إيران.
[1] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص387.
[2][2] الإسراء: الآية111.
[3] قوله×: «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربّنا بالحقّ». القمّي، الشيخ عبّاس، مفاتيح الجنان: ص263. ونقلها أيضاً: الجوهرجي، الشيخ محمد صالح، ضياء الصالحين: ص323 في زيارة وارث. كما ذُكرت في بقية الزيارات.
[4] الأعراف: الآية43.
[5] اُنظر: ابن عاشور، محمد بن الطاهر، التحرير والتنوير: ج9، ص132ـ133.
[6] الجوهرجي، الشيخ محمد صالح، ضياء الصالحين: ص324.
[7] اُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج8، ص116.
[8] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص388.
[9] المصدر السابق: ص393.
[10] الأحزاب: الآية56.
[11] اُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص338ـ 339.
[12] لقد أورد هذه الأخبار المفسّرة للآية المباركة الكثير من مفسّري الجماعة، فضلاً عن مفسّري مدرسة أهل البيت^. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): ج20، ص320، وغيره كثير.
[13] الحسني، السيّد حيدر، عمدة الزائر: ص253. القمّي، الشيخ عبّاس، مفاتيح الجنان: ص654، زيارة عيدي الفطر والأضحى.
[14] البقرة: الآية156.
[15] البقرة: الآية157.
[16] اُنظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم: ج1، ص203.
[17] اُنظر: الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج1، ص441.
[18] المجلسي، محمد تقي، روضة المتّقين: ج5، ص452. وأيضاً: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج99، ص133.
[19] آل عمران: الآية8.
[20] الشيخ محمد رشيد رضا، تفسير المنار: ج3، ص89.
[21] الحسني، السيّد حيدر، عمدة الزائر: ص255.
[22] القمّي، الشيخ عبّاس، مفاتيح الجنان: ص786.
[23] النور: الآية36.
[24] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج19، ص189.
[25] اُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج15، ص126ـ127.
[26] اُنظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية: ج32، ص250، حرف القاف، لفظة (القبر)، تحت عنوان: تطيين القبر وتجصيصه والبناء عليه. وغيره الكثير من مصادر الخاصّة والعامّة يصل الى حدِّ الإجماع الإسلامي عليه، وقد تناول هذا الموضوع بإسهاب موقع ويكي شيعة الإلكتروني: https://ar.wikishia.net البناء على القبور.
[27] الحسني، السيّد حيدر، عمدة الزائر: ص252.
[28] المؤمنون: الآية29.
[29] ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير: ج19، ص47.
[30] المجلسي، محمد تقي، روضة المتّقين: ج5، ص452. ومصادر أُخرى.
[31] آل عمران: الآية18.
[32] اُنظر: الفخر الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: ج7، ص219.
[33] الأنعام: الآية19.
[34] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج3، ص113ـ114.
[35] اُنظر: الفخر الرازي، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب: ج7، ص219.
[36] الجوهرجي، محمد صالح، ضياء الصالحين: ص334.
[37] آل عمران: الآية53.
[38] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج6، ص453.
[39] الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي، المزار: ص215.
[40] الأنبياء: الآيتان 26ـ 27.
[41] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص526.
[42] الصفّ: الآية9.
[43] اُنظر: الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج18، ص297ـ 299.
[44] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص405.
[45] الأعراف: الآية157.
[46] البقرة: الآية5.
[47] اُنظر: ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير: ج10، ص138ـ 139.
[48] الحسني، السيّد حيدر، عمدة الزائر: ص190. القمّي، الشيخ عبّاس، مفاتيح الجنان: ص649.
[49] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص412.
[50] النساء: الآية73.
[51] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج8، ص540.
[52] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص527.
[53] القمّي، الشيخ عبّاس، مفاتيح الجنان: ص646.
[54] الأحزاب: الآية33.
[55] اُنظر: الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج13، ص241.
[56] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص528.
[57] آل عمران: الآية31.
[58] آل عمران: الآية146.
[59] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص387.
[60] المصدر السابق: ص420ـ421.
[61] اُنظر: ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير:ج4، ص116ـ117.
[62] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص527.
[63] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص391.
[64] الحسني، السيّد حيدر، عمدة الزائر: ص253.
[65] النحل: الآية125.
[66] الطباطبائي: محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص371.
[67] القمّي، الشيخ عبّاس، مفاتيح الجنان: ص682.
[68] الحجر: الآية99.
[69] اُنظر: ابن كُثير، أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير ابن كثير: ج2، ص581.
[70] الأنبياء: الآيات16ـ 18.
[71] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص529ـ 531.
[72] القصص: الآية41.
[73] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج3، ص124.
[74] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص532.
[75] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص424.
[76] إبراهيم: الآية41.
[77] اُنظر: محمد أبو زُهرة، زهرة التفاسير: ج8، ص4046.
[78] الحسني، السيّد حيدر، عمدة الزائر: ص202.
[79] آل عمران: الآية169.
[80] السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور: ج٢، ص٩٥ـ96، نقلاً عن الشيرازي، الشيخ ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج2، ص779.
[81] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص411ـ412.
[82] الأنبياء: الآية28.
[83] يونس: الآية18.
[84] الزمر: الآية3.
[85] النساء: الآية48.
[86] اُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج14، ص277.
[87] المدّثر: الآية48.
[88] اُنظر: ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير: ج30، ص328.
[89] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار: ص385.
[90] الحسني، حيدر، عمدة الزائر: ص202.
[91] إبراهيم: الآيتان28ـ 29.
[92] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج17، ص5ـ 6.
[93] المائدة: الآية78.
[94] ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير: ج6، ص122.
[95] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص418.
[96] المصدر السابق: ص421.