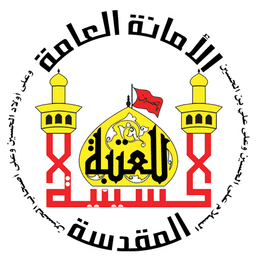بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقيّة وسعادته الأبديّة المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدّد خيارات الإنسان الصحيحة، وفي ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله} على سائر المخلوقات، واحتجّ عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)[1]، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر، ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله ، إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)[2]، وبهما تُسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمّة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[3]، فكانت الإجابة: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)[4]، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاء الأئمّة^ ومبتغاهم من الله لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»[5].
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيّات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه سيرة الأنبياء والأئمّة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار؛ لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسّسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبيّ أو وصي، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أُنيطت بهم^، كما أخبر بذلك في قوله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)[6]، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقيّة سِيَر الأنبياء^، كما أنّ سيرة الأئمّة^ ليست كبقيّة سِيَر الأوصياء السابقين، كما أنّ التفاوت في سِيَر الأئمّة^ فيما بينهم ممّا لا شكّ فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقيّة الأئمّة^.
والإمام الحسين× تلك الشخصيّة القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة الذين دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الرباني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصيّة العظيمة التي ملأت أركان الوجود، تعلَّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفيّة والعمليّة، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمسّ الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قِبَل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم، وأفنوا أغلى أوقاتهم، وزهرة أعمارهم؛ لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفيّة التي تركها× للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفيّة في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: هي أكثر ممّا تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعدّدة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤوليّة المهتمّين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق؛ بادرت الأمانة العامّة للعتبة الحسينيّة المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكريّة والعلميّة حول شخصيّة الإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى وبالأساس بمسك هذا الملف التخصّصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسيّة، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة، التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميين ـ على شخصيّة الإمام الحسين×، ونهضته المباركة، وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطّة مبرمجة، وآليّة متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصّين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلميّة التخصّصيّة، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفِّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينيّة المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصيّة الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلميّة في المؤسّسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسَّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلميّة في المجال الحسيني، تمّ تحديد مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهمّيته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويّات المعتمد في المؤسّسة تمّ اختيار المشاريع العلميّة الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعيّة للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينيّة التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلميّة وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها، يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث الحسيني، وقد تمّ العمل على نحوين:
الأوّل: التحقيق في المقاتل الحسينيّة، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، وذلك تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينيّة التي لم تُطبع إلى الآن؛ وقد قمنا بجمع عدد كبير من المخطوطات القيّمة، التي لم يطبع كثير منها، ولم يصل إلى أيدي القرّاء إلى الآن.
الثاني: استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسّسة، لغرض طباعتها ونشرها بعد إخضاعها للتقويم العلمي من قبل اللجنة العلميّة في المؤسّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وتأييد صلاحيتها للنشر، تقوم المؤسّسة بطباعتها.
الثاني: مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصلّية متخصّصة في النهضة الحسينيّة، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينيّة وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانيّة، والاجتماعيّة والفقهيّة والأدبيّة في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلّات العلميّة الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلميّة الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينيّة
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبّع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونيّة، وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علميّ تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: الموسوعة العلميّة من كلمات الإمام الحسين×
وهي موسوعة علميّة تخصّصيّة مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون العمل فيها من خلال جمع كلمات الإمام الحسين× من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلميّة، والعمل على دراسة هذه الكلمات المباركة؛ لاستخراج نظريّات علميّة تمازج بين كلمات الإمام× والواقع العلمي. وقد تمّ العمل فيه على تأليف موسوعتين في آن واحد باللغتين العربيّة والفارسيّة.
الخامس: قسم دائرة المعارف الحسينيّة الألفبائيّة
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام، وبلدان، وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب الحروف الألفبائيّة، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة بلغةٍ عصـريّة وأُسلوبٍ حديث، وقد أُحصي آلاف المداخل، يقوم الكادر العلمي في هذا القسم بالكتابة عنها، أو وضعها بين يدي الكُتّاب والباحثين حسب تخصّصاتهم؛ ليقوموا بالكتابة عنها وإدراجها في الموسوعة بعد تقييمها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة العلميّة.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعيّة
يتمّ العمل في هذا القسم على مستويين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعيّة التي كُتبتْ حول النهضة الحسينيّة، ومتابعتها من قبل لجنة علميّة متخصّصة؛ لرفع النواقص العلميّة وإدخال التعديلات أو الإضافات المناسبة، وتهيئتها للطباعة والنشر. الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة ـ يضمّ العنوان وخطّة بحث تفصيليّة ـ من قبل اللجنة العلميّة في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعيّة، وتوضع في متناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
الهدف من إنشاء هذا القسم إثراء الساحة العلميّة بالتراث الحسيني عبر ترجمة ما كتب منه بلغات أخرى إلى اللغة العربيّة، ونقل ما كتب باللغة العربيّة إلى اللغات الأخرى، ويكون ذلك من خلال إقرار صلاحيّة النتاجات للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ذلك إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيّات، والمواقع الإلكترونيّة، والكتب، والمجلّات والنشريّات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضيّة الحسينيّة بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقيّة المؤسّسات والمراكز العلميّة في شتّى المجالات. ويقوم هذا القسم بإصدار مجلّة شهريّة أخباريّة تسلّط الضوء على أبرز النشاطات والأحداث الحسينيّة محليّاً وعالميّاً في كلِّ شهر ، بعنوان: مجلّة الراصد الحسيني.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلميّة
يعمل هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكريّة متخصّصة في النهضة الحسينيّة، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، وتتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلميّة في المؤسّسة، وكذا سائر الباحثين والمحقّقين، وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينيّة وفق الأدوات الاستنباطيّة المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة
يضمّ هذا القسم مكتبة حسينيّة تخصّصيّة تعمل على رفد القرّاء والباحثين في المجال الحسيني على مستويين:
أ ـ المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة، والتي تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسَّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصُّصها.
ب ـ المجال الإلكتروني، إذ قامت المؤسّسة بإعداد مكتبة إلكترونيّة حسينيّة يصل العدد فيها إلى أكثر من ثمانية آلاف عنوان بين كتب ومجلّات وبحوث.
الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني
يتوزّع العمل في هذا القسم على عدّة جهات:
الأُولى: إطلاع العلماء والباحثين والقرّاء الكرام على نتاجات المؤسّسة وإصداراتها، ونشـر أخبار نشاطات المؤسّسة وفعّاليّاتها بمختلف القنوات الإعلاميّة ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع.
الثانية: إنشاء القنوات الإعلاميّة، والصفحات والمجموعات الالكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي كافّة.
الثالثة: العمل على إنتاج مقاطع مرئيّة في الموضوعات الحسينيّة المختلفة، مختصرة ومطوّلة، وبصورة حلقات مفردة ومتسلسلة، فرديّة وحواريّة.
الرابعة: إعداد وطباعة نصوص حسينيّة وملصقات إعلانيّة، ومنشورات حسينيّة علميّة وثقافيّة.
الخامسة: التواصل مع أكبر عدد ممكن من القنوات الإعلاميّة والصفحات والمجموعات الالكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتزويدها بأنواع المعلومات من مقاطع مرئيّة ومنشورات وملصقات في الموضوعات الحسينيّة المختلفة، الشاملة للتاريخ، والسيرة، والفقه، والأخلاق، ورد الشبهات، والمفاهيم، والشخصيّات.
الثاني عشر:قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصِّص، يقوم بنشر إصدارات وفعاليّات مؤسَّسة وارث الأنبياء، وعرض كتبها ومجلّاتها، والترويج لنتاجات أقسامها ونشاطاتها، وعرض الندوات والمؤتمرات والملتقيات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسّسة، ومجمل فعّاليّاتها العلميّة والإعلاميّة. بالإضافة إلى ترويج المعلومة الحسينيّة والثقافة العاشورائيّة عبر نشر المقالات المختلفة، وإنشاء المسابقات الحسينيّة، والإجابة عن التساؤلات والشبهات.
الثالث عشر: قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج
يتكفّل هذا القسم بإعداد الدورات الحسينيّة في المباحث العقديّة والتاريخيّة والأخلاقيّة، ولمختلف الشرائح والمستويات العلميّة، وكذلك إقامة دورات تعليميّة ومنهجيّة في الخطابة الحسينيّة، كما يضطلع هذا القسم بمهمّة كبيرة، وهي إعداد مناهج حسينيّة تعليميّة وتثقيفيّة لمختلف الفئات وعلى عدّة مستويات:
أوّلاً: إعداد مناهج تعليميّة للدراسات الجامعيّة الأوليّة والدراسات العليا.
الثاني: إعداد مناهج تعليميّة في الخطابة الحسينيّة.
الثالث: إعداد مناهج تعليميّة عامّة لمختلف شرائح المجتمع.
الرابع: إعداد مناهج تثقيفيّة عامّة.
الرابع عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصّص وبأقلام علميّة نسويّة في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، ورفد أقسام المؤسّسة بالنتاجات النسويّة، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبيّة، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الخامس عشر: القسم الفنّي
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينيّة التي تصدر عن المؤسّسة، من خلال برامج إلكترونيّة متطوِّرة، يُشرف عليها كادر فنيّ متخصِّص، يعمل على تصميم أغلفة الكتب والإصدارات، والملصقات الإعلانيّة، والمطويّات العلميّة والثقافيّة، وعمل واجهات الصفحات الإلكترونيّة، وبرمجة الإعلانات المرئيّة والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها أقسام المؤسّسة كافّة.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.
كوثر كربلاء
إنّ عطاء نهضة الإمام الحسين× لا ينتهي ولا يحدّ، فهو يتجدّد دائماً، وما زال نبعه الصافي يروي القلوب العطشى بالمعارف والعلوم والقيم والمبادئ الإلهيّة، فهذه النهضة كوثر عذب ينهل منه الخواص، وخواص الخواص، كما ويرتوي منه عامّة الناس كلّ بحسب سعيه وعمله وقدرته.
وفي هذا الكتاب (كوثر كربلاء) لآية الله العظمى الشيخ عبد الله الجوادي الآملي (دام ظله)، تجد لطائف لخواص الخواص، ومعارف وعلوم للخواص، وقيم ومبادئ لعموم الناس.
فتحدّث سماحته عن الحقيقة المطلقة، وعن الإنسان الكامل وعناصره الرئيسية، وما يرتبط بذلك، وعن رسالة الأمّة الإسلاميّة وعالميّتها، ومواضيع كثيرة أخرى، وكيفيّة ارتباطها بنهضة الإمام الحسين×، وأنّ نهضته المباركة كوثر ومعين يمكن أن تُستقى منه المعارف في مختلف المجالات العلميّة والعمليّة.
فهذا الكتاب عزيزي القارئ يخاطب مختلف المستويات المعرفيّة والفكريّة، وهي تعكس قدرة مؤلّفه واضطلاعه بإيصال المعلومة القيّمة بطريقة لا تضرّ بعمقها، ولا تبقيها خارج متناول فهم عامّة الناس.
وفي الختام نقدّم الشكر والثناء للدكتور الشيخ حبيب عبد الواحد الساعدي الذي أخذ على عاتقه ترجمة هذا الكتاب في قسم الترجمة في مؤسسة وارث الأنبياء، وكذا الشكر للدكتور الشيخ محمّد الحلفي مسؤول قسم الترجمة في المؤسسة على مراجعة الكتاب وإبدائه الملاحظات القيّمة.
نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلميّة في
مؤسّسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
وإيّاه نستعين
الحمد لله حمداً أزليّاً وسرمديّاً كما هو أهله، والصلاة على الأنبياء ـ لا سيّما خاتمهم ـ صلاة دائمة كما هم أهلها، والسلام على آل طه وياسين ـ لا سيّما خاتم الأوصياء المهدي الموعود# ـ بهم نتولّى ومن أعدائهم نتبرّأ.
للإسلام أحكام نافعة في سلوك الطريق الإلهي، وحِكَمٌ مفيدة للوصول إلى المقصد وشهود المقصود. وما يُطلق عليه عنوان المتاع في الإسلام، إنّما هو لإيصال المسافر إلى المقصد، وما يُطلق عليه عنوان الشهود القلبي فهو لنيل المقصود ورؤيته بقلب بصير؛ والمقصد الأبرز هو القرب الإلهي، والمقصود الأعلى هو المعرفة الشهوديّة لله}.
وبالنظر إلى وضوح امتناع معرفة الحقيقة المطلقة، والذات اللامتناهية لله، فسيكون العنصرالذي يتمحور حوله الكلام في كلّ ما قيل أو يقال، وفي كلّ مقالة قُدّمت أو تُقدّم، معلوماً وهو الإطار الممكن من المعرفة، والمنطقة المسموح بدخولها، لا الدائرة المستحيلة ومنطقة الامتناع.
وبتحليل مختصر لهذا الأمر يتضح أنّ الهدف من نهضة كربلاء ليس الوصول إلى منطقة الامتناع، ولا الاقتصار على الهجرة الصغرى والجهاد الأصغر، ولا الاكتفاء بالهجرة الوسطى والجهاد الأوسط، وإنّما محاولة الفوز والانتصار على مستوى الهجرة الكبرى والجهاد الأكبر، وقد نال هذا الهدف السامي الإمام الحسين× بأكمل صوره، بحيث لا يتيسّر لأحد هجرة أعظم من هجرته×، ولا حظى أحد بجهاد أعظم من جهاده×.
ولبيان المنطقة المحظورة والممكنة من معرفة الله ومن أجل تفسير الأقسام الثلاثة للهجرة، وتوضيح أنواع الجهاد الثلاثة نأتي على ذكر عدّة أصول باختصار، ونضعها بين يدي النخب والباحثين من القرّاء، ونستفتح بها مقدّمة كتاب دوّناه لعامّة الناس حول نهضة سيّد الشهداء×، لتتضح بها الخطوط العامّة للكتاب، وتساعدنا في التحليل العقلي والنقلي لتلك الهجرة والثورة الجهاديّة، وإذا لم يجد الخواصّ في مطاوي الكتاب بحثاً ينتفعون به فإنّ الأوحدي منهم سيجد في هذه المقدّمة ضالّته، أو تُشكّل هذه المقدّمة أرضيّة مناسبة لتأمّلهم أكثر من ذي قبل؛ لأنّ كوثر كربلاء يخاطب الأخص كما يخاطب الخواص وعامّة الناس، وتلك الأصول هي:
إنَّ الحقيقة المطلقة بإلاطلاق الذاتي هي الله}، والمقصود من إطلاقها الذاتي هو إطلاق الهويّة لا الماهيّة، وهي أجلّ وأسمى من أن تحتاج في تحقّقها العيني إلى محصّل مفهومي أو مقيّد وجودي؛ وذلك لأنّ تحصيل كلّ مفهوم وتحقيق كلّ قيد إنّما هو بإفاضته، وهذا النوع من الإطلاق منحصر بالهويّة السرمديّة لله، ومعنى هذا النوع من الإطلاق الوجودي نزاهته عن كلّ أنواع التركيب، ما كان من المادّة والصورة، أو من الجنس والفصل، أو من الجوهر والعرض، أو من الموضوع والعارض، أو من الحقيقة والاعتبار، أو من النصف والربع، أو من الجزء والكل، فضلاً عن الوجود والعدم، وعلى حدّ تعبير الحكيم السبزواري&: «شرّ التراكيب»[7]، فهكذا موجود بسيط غير متناه بلا ريب، وإلّا لابتلي بأسوء التراكيب، وأعني التركيب من الحدّ والمحدود، أي: التركيب من الجنبة الوجوديّة وهي المحدود، والعدميّة وهي الحد.
إنَّ بساطة هذه
الحقيقة تمنع من أيّ تجزئة وهميّة أو عقليّة أو عينيّة، وعدم تناهي تلك الحقيقة
مانع عن أيّ إحاطة أو شموليّة، ولذا فإنّ إدراك هذه الحقيقة
ـ أي الله} ـ لغيره محال كما قال الأستاذ السيّد الإمام
الخميني+: «فإنّ الحقّ
بمقامه الغيبي غير معبود، فإنّه غير مشهود ولا معروف، والمعبود لا بدّ أن يكون
مشهوداً أو معروفاً»[8].
والسرّ في استحالة إدراك الهويّة المطلقة لله تعالى هو أنّ العقل المفكّر يضلّ يدور حائراً في نطاق المفهوم، والله منزّه عن المفهوم، والقلب الذي هو مركز الشهود يدور في نطاق محدود، والله مبرّأ من الحد. نعم، يمكن تصوّر مفهوم وجود لامتناهي، وهذا المفهوم لا متناهي بالحمل الأولي، ومتناهي بالحمل الشائع في مقابل المفاهيم الأخرى؛ ومحدود لأنّه غير المفاهيم الأخرى للبشر وقبل ذلك غير مقدور وغير معقول وليس محلاً للتكليف، كما أُشير إلى ذلك في بعض النصوص، حيث قال أبو عبد الله×: «لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عنّا مرتفعاً؛ لأنّا لم نكلّف أن نعتقد غير موهوم، ولكنّا نقول كلّ موهوم بالحواس مدرَك، فما تجده الحواس وتمثّله فهو مخلوق»[9].
والمراد أنّ ذات الله ليست مفهوماً كي يدركه العقل، وليست محدودة كي يراها القلب، والأمر الممتنع لا يمكن الحصول عليه لا بالفضل ولا بالتفضّل؛ وذلك لأنّ مجال الفضل محدود، وكذا دائرة التفضّل، ومن هذا المنظار فكما لا يمكن للهجرة الصغرى والوسطى الوصول إلى تلك الذات كذلك الهجرة الكبرى محرومة من نيلها؛ وإذا لم يكن للجهاد الأصغر والأوسط طريق إلى تلك الذات، فالجهاد الأكبر لا طريق له إلى ذلك أيضاً. وبناء على هذا، فلا بدّ من البحث عن أجواء كوثر كربلاء في دائرة أخرى.
الأصل الثاني: الإنسان الكامل والمعصوم
إنّ الإنسان الكامل والمعصوم هو مَن كان مثل سيّد الشهداء× جامع لميزات العالم والإنسان. فإذا كان بعض علماء الدين جامعاً للمعقول والمنقول، والبعض الآخر جامعاً للمعقول والمشهود، وجماعة قليلة أيضاً يجمعون بين المعقول والمنقول والمشهود، فلا يوجد عالمٌ اعتيادي جامعٌ للعالم الكبير والصغير وواجد للعالم والإنسان؛ والإنسان الوحيد الواجد لكلا هذين العالمين والجامع لهذين العالمين أعني (العالم والإنسان) هو الإنسان الكامل المعصوم.
توضيح ذلك:
1ـ العالم يحتوي على سماوات وأرضين وملائكة وإبليس، كان ولا زال.
2ـ إنَّ الله} خلق خليفته ـ أي: الإنسان الكامل والمعصوم ـ وعلّمه الأسماء الحسنى.
3ـ أمر الله} الملائكة وإبليس بالسجود للإنسان الكامل الذي هو خليفة الله، وأوصاهم بإجلاله وإكرامه وعدم التمرّد عن ذلك.
4ـ الملائكة أطاعوا الله تعالى وإبليس لم يسجد.
5ـ الملائكة بصدد الانسجام دائماً مع خليفة الله، وأصبح كلّ واحد منهم موكَّلاً بتقديم خدمة له في مجال معيّن.
6ـ إبليس دائماً يرصد ما يقوم به الإنسان الكامل من برامج تبليغيّة وتعليم الكتاب والحكمة وتزكية النفوس، ويحاول عرقلتها وعدم إجرائها بالشكل الصحيح، بالرغم من أنّه ليس لديه سلطة مباشرة على ذلك، (وإنّ قصّة وسوسة إبليس لآدم والتسبّب في خروجه من الجنّة وهبوطه إلى الأرض مطلب معقّد قد ذكرنا جانباً منه في تفسيرنا الموسوم بـ تسنيم).
7ـ السرّ في عدم تسلّط إبليس على الإنسان الكامل هو أنّه عاجز عن المساس بمقام الإخلاص الرفيع الذي يتمتّع به المخلَصون بالفتح، قال الله}: (ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ)[10].
8ـ يبلغ العالَم في نهاية المطاف هدفه السامي، فيشرب من قدح العدل بيد ساقيه، بل يرويه، فيملأ العالم المظلوم عدلاً، وفي ظلّ حكومة الإنسان الكامل المعصوم القائمة على أساس العقل ومحوريّة العدل يُقرّ عين العالم المظلوم بالعدل والقسط.
بيّنا حتّى الآن النظام العام للعالم الذي ارتسم منذ القدم في أذهان الجميع، والإنسان الكامل المعصوم حضوره مشهود في هذا النظام العالمي.
وأمّا العالم الصغير والذي هو نسخة من ذلك العالم الكبير فبيانه كالتالي:
1ـ إنّ الإنسان في ثقافة القرآن الحكيم يتمتّع بالكرامة.
2ـ دليل كرامته هو خلافته لله الكريم، وخليفة صاحب الكرامة الأصيلة يتنعّم بالكرامة بالتبعيّة.
3ـ خلافة الإنسان من قبل الله تعالى بمعنى أنّه يفهم حكم الله تعالى ويذعن له ويمتثله، ويبادر إلى نشره وتطبيقه، فمن جعل أساس عمله رأيه ـ لا حكم الله ـ فهو ليس خليفة لله أبداً؛ لأنّ الخليفة من يجعل أحكام (المستخلف عنه) هي محور جميع أعماله، وإلّا كان جلوسه على مسند الخلافة غصباً، ومثل هذا الغاصب مطرود بقوله: (ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ)[11] فلا سهم له من الخلافة ولانصيب يناله من الكرامة.
4ـ خلافة الانسان لله} وهي منشأ كرامته ونتيجة إلهام إلهي خاص في دائرة العلم الشهودي ودائرة التحقّق العيني، فكما ألهم الله} خليفة العالم الأكبر العلم بالأسماء الحسنى كذلك ألهم خليفة العالم الأصغر سبيلي الفجور والتقوى: (ﭬ ﭭ ﭮ)[12] بنحوٍ يكون فيه بناء فطرة الإنسان متقوّم بقضايا يطلق عليها الفطريات، إذ الإنسان بفطرته يميل إلى أمور كالعدل والحقّ والصدق والأمانة التي يعبّر عنها بالفطرية.
وبعد غرس أصول الحكمة النظريّة والعمليّة صدر الأمر إلى جميع القوى الإدراكية والمحركيّة وقوى الفكر ودوافعه بأن تطيع الخليفة الإلهي في العالم الصغيرـ أي الفطرة العالِمة بالفجور والتقوى والتي تميل إلى التقوى والجمال والصدق والعدل ـ وتعظّمه، وتنتفع من مدّخراته الإلهاميّة في مجال العلم والتزكية، ورحّب العقل والقوى المتّسقة معه بهذا الأمر، فأكرموا الفطرة وسعوا في تبجيلها علميّاً وعمليّاً ولا زالوا كذلك، ولكنّ الهوى والنزوة يهتفان بنغمة خالية عن التوازن (ﭚ ﭛ ﭜ)[13] وبدءاً بالتمرّد ومحاربة القوى المؤيّدة للفطرة وألهبا جبهة الجهاد الأوسط، يضربان طبول الحرب باستمرار، ويتعالى منهم نداء هل من مبارز؟ وإلى جانبه يتردّد صدى جهنّم قائلة: (ﯽ ﯾ ﯿ)[14]، وهي مترقّبة تترصّد الحصول على أسير: «كم من عقل أسير تحت هوى أمير»[15].
5ـ إنّ الإنسان الكامل المعصوم كالحسين بن علي÷ يمتلك كرامة حقيقية، فبقطع النظر عن الخلافة الظاهريّة فهو لديه كذلك الخلافة الباطنيّة، وقد حمل أمانة الخلافة على أحسن وجه تلك الأمانة التي لايقوى على حملها ملك ولا فلك ، وكما أنّه قد حظى بتعلّم أسماء الله الحسنى بكلّ جدارة، فهو كذلك استفاد بصورة كاملة من تعلّم وإلهام النفس فجورها وتقواها، وهكذا أصبح الملائكة مأمورين بالسجود له وتعظيمه، وقد امتثلوا هذا الأمر إلّا إبليس أبى عن طاعة هذا الأمر، لكنّ الإنسان الكامل المعصوم صار مانعاً من تمرّد الشيطان، وأخضعه وأوقفه عند حدّه كي لا يدنو من مقام إخلاص الذين وصفهم القرآن بـ (المخلَصين)، فحقيقة الإمام الطاهرة والمقدّسة سليلة الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة والمصونة من رجس الجاهليّة ومدلهمّات ثياب الظلم والجور، سعت للحفاظ على منصب الخلافة الرفيع، وجَعَلت جميع أفكارها ودوافعها ورغباتها تحت هدى الفطرة، مترنّمةً بقوله: (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)[16]. وملك العقل والعدل خضع للإمام في ساحة قدسه النظري، وشيطان الشهوة والغضب يجول حول الهوى يريد منه النهوض معه سعياً وراء استمرار تأجيج جبهة الجهاد الباطني، ولكنّه ما زال مخذولاً ومنكوباً بالشعار العلوي الأصيل: «إنّما هي نفسي أُروّضها بالتقوى»[17]، الذي جعل مصباح الباطن يتوهج نوراً وتغلّب ملك العقل على غول الجهل، وملك العدل على الوقوع بحبائل الأجوفين، لتبقى شمس الإمامة الملكوتية مضيئة دون كسوف، ويبقى قمر العصمة المقدّسة منيراً بلا خسوف، ولتظل أرضيّة العدل والحكم خالية من الزلازل، وتبقى أجواء الولاية المعطّرة صافية وخالية من غبار الهوى.
فهكذا إمام همام مثل سيّد الشهداء× مجمع العالم الأصغر والأكبر، ومسجد الملائكة والعقل، وقبلة المُلك والملكوت، ومطاف الناسوت والجبروت الإمكاني لا الوجوبي، وقميص الخلافة لا يليق إلّا بشمائله، وكأس الولاية لا يكون إلّا في يده، وتاج الكرامة لا يوضع إلّا على رأسه، ونعلا القداسة اللذان لايخلعان، لا يليقان إلا بقدميه، وعنده العصى واليد البيضاء وإحياء المسيح، ولديه معاجز وكرامات أولياء الله الآخرين.
وما أُنشد من أبيات شعر بحقّ الإمام الرضا×:
|
نسيم قدسي يكي گذر کن فتاده بیهوش هزار موسی[18] |
فهي تحكي عن مخطط بياني واضح للإنسان المعصوم الكامل الجامع للعالمَين.
الأصل الثالث: العناصر الرئيسيّة الثلاث في الإنسان الكامل المعصوم×
يتّصف الإنسان الکامل المعصوم× بثلاثة عناصر رئيسيّة لا نظير إمكاني لها في الخلق، وهذه العناصر الثلاثة الرئيسيّة ما رأى أحدٌ ندّها، ولا نظيرها ولا شبيهها، ولم يصل أحد إلى مقامها، ولم يطف مطافها، ولم يُحرِم أحد للدخول إلى حرمها، ووزان هذه العناصر الثلاثة في عالم الإمكان مثل وزان الوجوب في نداء (لَنْ تَرَانِي)[19]، وبالتأكيد هي: (مَعْلُومٌ)، و(عِلْمٌ) و(مُعَلّمٌ)، أي: إنّها معلوم الإنسان الكامل المعصوم مثل الحسين بن علي÷، وعلمه الخاص، والمعلّم الرئيسي لتلك العناصر الثلاثة المخصوصة وغير الميسورة لغير الإنسان الجامع للعالم الصغير والكبير، والواجد للملك والملكوت، وصاحب الناسوت والجبروت الإمكاني (لا الوجوبي). وفيما يلي توضيح لهذه العناصر المتقدّمة:
1ـ عالم الخلق يدار بواسطة أسماء الله الحسنى: وتلك الأسماء المباركة ليست مجرّد ألفاظ، وعندما يتلفّظ بها يحدث أمراً ما في هذا الكون، وليست مفاهيم حتّى يبعث تصورها على إيجاد حياة ، أو انتقال حي إلى دار الآخرة، وإنّما هي حقائق عينيّة، ونتيجة التسلّط عليها والقدرة والاقتراب منها يدبّر نظام الكون.
وما جاء في دعاء كميل: «وبأسمائك التي ملأت أركان كلّ شيء»[20]، وما ورد ذكره في دعاء السمات[21] من آثار تكوينية يدلّ على الوجود الحقيقي لهذه الأسماء لا الاعتباري، والعيني لا الذهني، والخارجي لا اللفظي. فهي حقائق عينيّة وخارجيّة بها ظهرت السماء والأرض، وبحضورها المؤثّر وظهورها المدبّر أُنيطت الأمور التكوينيّة الأخرى.
هذه الأسماء الحسنى إنّما هي تجلّيات لله سبحانه في عالم الإمكان ويمكن نيلها وأن يحظى الإنسان بها، وهذا بخلاف المسمّى الواحد الأحد والذي هو فوق كلّ إمكان، والمطّلع عليها بالإذن الإلهي سيتعرّف على مفاتيح عالم التكوين، وقد حظى بهذه الأسماء الحسنى واطّلع عليها الناس الكمّل المعصومون من آدم× حتّى الخاتم، وإن كان التفاضل بينهم غير خفي، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ)[22] وقال الله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ)[23] ومؤشّر ذلك هو شفاعة الإنسان الكامل المعصوم× الذي هو الحجّة الإلهيّة البالغة، وإيجاد الكون وبقاؤه، وكلّ شؤونه العلميّة والعمليّة منوط بالإرادة الإلهية الحكيمة التي لا يصدر منها شيء دون حكمة «لا تبدّل حكمتَه الوسائلُ»[24]، ولن يفوّض أيّ عمل تكويني لغير الله تعالى، وأسماء الله الحسنى هذه التي يدار بها الكون ـ والتي هي ليست إلّا تجلّيات مختلفة لله تعالى ـ هي معلومات الإنسان الكامل المعصوم× التي يعلم بها.
2ـ العلم بتلك الأسماء الحسنى والتي هي حقائق عينية، لا يوجد في كتب اللغة وتفسيرات الفقه والأصول والحديث، كما أنّه لن يوجد أيضاً في كتب الفلسفة والكلام والعرفان النظري؛ لأنّ الحقيقة العينية لا يمكن الوصول إليها عن طريق العلم الحصولي الذي تتولّاه العلوم العقليّة والنقليّة، فوظيفة مثل هذه العلوم تحصيل المعاني النظرية (تصوراً وتصديقاً) عن طريق المعاني البديهيّة (التصوريّة والتصديقيّة)، لا يمكن أبداً إدراك الموجود العيني والخارجي بواسطة التصوّر والتصديق الذهني، مثلاً: حقيقة العسل حلو الطعم، ولا يُدرك هذا الطعم من خلال فهم معنى النحل وخلية النحل، والورد، وامتصاص عصارته و...
فيقول طالب العلم الحضوري ـ لا الحصولي ـ ومن هو بصدد الوصول إلى عين الشيء ـ لا ذهنيا ـ وبصدد الحصول على المصداق ـ لا المفهوم ـ :
|
آفت إدراك قال است وحال |
أي إنّ الإدراك الحصولي يعاني من مشكلة، وهي أنّه لا يتمكّن من الإيصال إلى حقيقة الشيء وواقعه، ولا يمكن التعرّف على المدرَك الحصولي بمدرَك حصولي آخر؛ لأنّ المدرَك الحصولي الآخر من سنخ المدرَك الحصولي الأوّل وهو من قبيل تعريف المجهول بالمجهول، وشبّه الشاعر ذلك بتطهير الدم بالدم.
أي: إنّ المعنى النظري والمعقّد هو بحكم الدم، ومصداقه العيني بمثابة الماء الجاري المطهّر، ويُحلّ المفهوم النظري بالمصداق الخارجي لا بمفهوم ذهني آخر بديهي، وحلُّ ذلك المعنى النظري المعقد بمفهوم آخر ولو كان المفهوم الآخر بديهياً إنّما هو من قبيل تطهير الدم بدم آخر، وهو محال، فالطريق الوحيد للوصول إلى الأسماء الحسنى هو العلم الشهودي العيني لا الحصولي الذهني، وشهود العالم الخارجي الخالص لا مشاهدة المثال المتّصل، ولا شهود الخارج المشوب بالداخل؛ لأنّ مشاهدة المثال المنفصل غير الخالص المشوب بالمثال المتّصل لا تكون أبداً علماً شهوديّاً معصوماً بأسماء الله الحسنى.
3ـ مُعَلِّمُ المعلوم العيني، أي: (أسماء الله الحسنى) بتعليم إشهادي، ثمرته العلم الشهودي بحقائق العالم، وهذا النحو من التعليم مختصّ بالله تعالى فحسب. وإن كانت جميع العلوم كبقيّة الأشياء الممكنة تتحقّق من قبل الله تعالى، وليس لأحد فيها تأثير بالأصالة، وقد يحتاج أحياناً لتحقّق العلوم مبادئ وعلل وسطى، ومن هذه الجهة لا يمكن أن يكون شيء من هذه العلوم أو غيرها صادراً أو ظاهراً أوّلاً، كما لا تعدّ فيضاً بلا واسطة، أمّا في التعليم الشهودي لأسماء الله الحسنى فليس هناك أيّ واسطة، ولم تكن أيّ حاجة لها، وإنّ الآية الكريمة: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا)[26] شاهدة على التعليم من دون واسطة؛ لأنّه لو كانت هناك وساطة لكان للملائكة المقرّبين أثر في حصول ذلك التعليم، والحال أنّ الملائكة متأخّرون عن الإنسان المعصوم الكامل من عدّة جهات:
أـ عدم اطّلاعهم على حقائق الأسماء التي عرضها عليهم؛ لأنّهم بعد قوله تعالى: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)[27] قالوا: (لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا)[28]، واعترفوا بعجزهم وجهلهم بتلك الحقائق.
ب ـ إنّ الله تعالى قد أطلع الملائكة على تلك المعارف والأسماء بواسطة الإنسان الكامل المعصوم×، ولم يُطلعهم على ذلك من دون واسطة.
ج ـ إعلام الإنسان الكامل المعصوم× للملائكة كان بطريقة الإنباء لا التعليم؛ وذلك لأنّ الآية الكريمة: (قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ... ) [29] لا يستفاد منها أكثر من الإنباء والإخبار، أي: إنّ الملائكة قد اطّلعوا على نبأ الأسماء عن طريق الإنسان الكامل المعصوم لا أكثر، فلو كان للملائكة استعداد للحصول على حقائق الأسماء ولو بمقدار الإخبار بها عن طريق الله تعالى مباشرة ومن دون واسطة لم يبخل الله تعالى عليهم بذلك، ولظهر لهم هذا الفيض ولحظى الملائكة بهذا الفوز.
الأصل الرابع: الإنسان الكامل المعصوم × كون جامع
يُطلق على الإنسان الكامل المعصوم× (كون جامع)؛ لأنّه التجلّي الكامل لجميع أسماء الله الحسنى، وبما أنّ لله في مقام الفعل والوجه ظهوراً واسعاً وشاملاً من جميع الجهات والجوانب إلى حدّ يكون مشهوداً بمرتبة دانية مع الحفاظ على المرتبة العالية، كما يستفاد ذلك من الكلام النوراني للإمام علي بن الحسين÷ الذي كان على عاتقه قيادة أعضاء ركب الحرّية والتحرّر وكأنّهم أسود مقيدة بالسلاسل، فتحمّلوا ـ رضا بما أراده الحقّ ودون جزع ـ عذابات أسر الأُمويين الأشرار والمروانيين المتكالبين والجلاوزة الذئاب، تسليماً لله وإحياءً للدين، حيث قال: «وأنت الله لا إله إلّا أنت الداني في علوّه والعالي في دنوّه»[30]. وتجلّيه التام أي: الإنسان الكامل المعصوم× فهو بإذن الله وإرادته حاضر أيضاً بالعرض في جميع المراتب، ومن هنا فهو أفضل من الملائكة، وهو الذي يعلّمهم حقائق الأسماء بمقدار الإنباء والإخبار، وهم بإذن الله وارادته يدبّرون عالم الإمكان: (فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا)[31].
وبناء على هذا لا يمكن افتراض وجود كمال حقيقي في عالم الخلق يفتقده خليفة الله الكامل، أو أن يكون غيره عِدلاً وقريناً له في ذلك الكمال؛ لأنّ جميع الكمالات الحقيقيّة ترجع إلى أسماء الله الحسنى، وأنّ العلم اللدنّي[32] خاصّ بالخليفة الحقيقي لله تعالى، إذن فجميع الكمالات الحقيقيّة هي من نصيب الإنسان الكامل المعصوم، وتُقدّر هذه الكمالات لغير المعصوم× بواسطته وبأذن ومشيئة الإرادة الإلهيّة.
إنّ قضيّة عشق العبادة هي مرحلة كمال العبادة كما روى ثقة الإسلام الكليني: «أفضل الناس مَن عشق العبادة»[33] ولها مراتب، أعلى تلك المراتب خاصّة بسلطان العاشقين، والعبادة المنطلقة عن العشق تختلف عن عبادة الخائفين، وعبادة التجّار الطامعين، فإنّ العبادة الأولى ناشئة من جنود الغضب وشؤونه والتي تكون بصدد الدفاع ودفع مصاعب الجحيم، والثانية ناشئة من جنود الشهوة وشؤونها والتي يسعى العبد من خلالها أن ينال ما يلائم طبعه بحثاً عن نعيم الجنّة، بل إنّ محبّة المحبوب هي مصدر توحيد الله والشوق إليه، بنحو تكون فيه مصونة من التثليث المعرفي، والتثنية المعرفيّة؛ وذلك لأنّ طائفة من العباد لديهم توجّه للعبادة والعابد بالإضافة إلى نظرهم للمعبود، فهم غير مصونين من مشكلة التثليث، وطائفة أخرى بالرغم من أنَّهم لا يرون العابد إلّا أنّهم يأخذون العبادة بنظر الاعتبار كالمعبود.
فهاتان الطائفتان محرومتان من الحبّ الخالص؛ وذلك لأنّه بحسب تعبير الحكيم المتألّه ابن سينا&: «من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني»[34]، إذا اختار الإنسان العرفان من دون الله فقد ابتلي بمحبوب آخر، أحدهما المعروف والثاني العرفان. وإذا نظر العابد إلى غير المعبود وطلبه وتوجّه إليه ـ أي: إنّه يرى غير ذات المعبود أيضاً ـ فقد ابتلي بشيء آخر باسم العبادة، وعليه فالمحبّة التي هي مرآة كبيرة عاكسة للنور، لا ينبغي أن تتلوّث بغبار الغضب والشهوة الأجنبيين عن المحبّة[35].
للعبادة مظاهر وتجلّيات، منها الأقسام الثلاثة للهجرة (الصغرى ـ الوسطى ـ الكبرى)، وأيضاً الدرجات الثلاث للجهاد: (الأصغرـ الأوسط ـ الأكبر) بعض عشّاق العبادة الإلهية لديهم شغف في مجال خاص، وليس لديهم حضور ولا ظهور في المجالات الأخرى، وطائفة أخرى لديهم في مدارج عبادتهم لله حضور في عدّة مجالات، لكن لا بالنحو الكامل والتام، وأمّا الأوحدي في العشق الإلهي فهو من لديه حضور كامل في جميع مراحل الهجرة وظهور كامل في جميع مراحل الجهاد، ومن الصفات الممتازة لهذا القسم اتصافه بالجمع السالم في كلّ هذه المراحل والمراتب، مقابل الجمع المكسّر للآخرين الفاقد لجميع مراحل الهجرة وأكمل مراتب الجهاد، وإن كان قد حاز على بعض مراحل هذه أو مراتب تلك، ولذا لو كان هؤلاء أصحاب نظر وبصر في ميدان النظر والشهود فإنّهم في ميدان العمل خائفون أو مبررون وبالعكس.
نعم يمكن أن تتوفّر للإنسان الكامل المعصوم جميع المعارف العلميّة والمعارك العمليّة على نحو الجمع السالم ولكنّه غير مأمور بالإقدام؛ وذلك لأنّ النهوض قبل الوقت، والإقدام قبل الموعد أو بعد فوات الأون لا يوافق الحكمة الإلهية؛ وهذا ما حدث لمولى الموحّدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب× حين شاهد عن قرب تحوّل استبرق الغدير وحريره إلى حصيرة السقيفة وباريتها، وبيع زمزم خمّ بمستنقع غمّ، وانقلبت طاولة العزّة العلوية إلى مذلّة تيم وعدي، وتبدّل جاه الأمّة الإسلامية إلى انحطاط الجاهليّة، وقد غصب الأثيم منصب المعصوم، وتقمّص قميص الخلافة، وامتدّت يده إلى قطب الرحى، وفي النهاية: «ارتدّ الناس بعد النبي’ (أي: عن الولاية) إلّا ثلاثة...»[36] فبرزت غدّة خبيثة من قبل جماعة من طلّاب الدنيا، على غرار ما حدث في قضيّة فدك: «كانت في أيدينا فدك من كلّ ما أظلّته السماء، فشحّت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله»[37].
وفي مثل هذه القضيّة الصعبة تصبح المصلحة الدينيّة في السكوت، والسكون، والصبر، والتحمّل، والحلم، ولذا فإنّ ذلك المناضل الذي لا نظير له ولا منافس في جبهة الحقّ، ولا منازع له في جبهة الباطل، ولا شبيه له في عالم الإمكان، قد أظهر بذراع (لا فتى) ومنطق (هل أتى) صلابته التي لا ريب فيها حيث قال: «فنظرت فإذا ليس لي معين إلّا أهل بيتي فضننت بهم عن الموت وأغضيت على القذى»[38].
والغرض أنّ السلطة القائمة على أساس العشق، وبذل النفس، وإيثار النفيس، مختصّة بسليمان كربلاء، واختصاص ذلك به لا يقف عند قولنا: (لا ينبغي لأحد من بعده)، بل يتعدّى ذلك إلى قولنا (لا ينبغي لأحد من قبله) فلا ينبغي ذلك لأحد منذ هبوط آدم حتّى واقعة كربلاء، ولا ينبغي لأحد ابتداء من حادثة كربلاء حتّى قيام الساعة ويوم المعاد، فلم يكن هذا الأمر مُقَدَّراً ومقدوراً لأحد، ولن يكون كذلك لأحد في المستقبل.
فإنّ تلك الثلّة شيبةً وشبّاناً وفتيةً، رجالاً ونساءً، سوداً وبيضاً كانوا قرابين اصطفّوا مُحرمين ينتظرون تقديم الأرواح، فكان وضوؤهم دماءهم الزكية، مردّدين الفرائض والنوافل في محراب القرب الإلهي، واستقبلوا الشهادة، وتركوا الأسر للسيّدة زينب الكبرى‘ وبقية الأسرى، وقد طوّعت بل أَسرت تلك الذوات المقدّسة بقيادة سيّد الساجدين× الأسرَ وصار في قبضتهم، وقيّدوه بالحبال والسلاسل، وجعلوا مجلسي الحكومة الأموية المستبدّة في الكوفة والشام مثاراً للسخرية، فما برحوا مستغرقين بالجمال والجلال الإلهي، وهم ينشدون نغمة التوحيد«ما رأيت إلّا جميلاً»[39]، فلم يشاهدوا شيئاً غير فنّ الشهادة الإلهيّة، والأسر الديني، وجمال التضحية في سبيل الله}، ولطافة الإيثار في سبيله، وقد أنشدوا بعملهم: «يصل الإنسان إلى مرتبة لا يرى غير جمال الله».
إن أمكن استعمال مصطلح (سلطنة العشق) في غير المعصوم× فهو استعمال نسبي لا نفسي، وهو استخدام إضافي لا مطلق، من قبيل إطلاق العبارة المعروفة: «ذي لهجة أصدق»[40] على أبي ذر&، وطبقاً للكلام النوراني للإمام الصادق× فإنّ هذا التعبير الرفيع والمشرّف لأبي ذر بالقياس إلى بقيّة الناس، دون الإمام المعصوم× ففضله كأفضليّة ليلة القدر على بقيّة الليالي، وهي لاتقارن بتلك الليالي أبداً. وعلّنا نحظى بقطرة من بحر كوثر كربلاء من الاطّلاع على مضمون هذه الأبيات الشعريّة:
|
اِستاد در برابر آن لشكر
عبوس |
الأصل الخامس: الإنسان الكامل المعصوم والموت
بالرغم من أنّ الإنسان مصون من الانعدام والفناء، إذ الموت ليس انعداماً وفناء، والإنسان يخرج منتصراً في ساحة الحرب عند صراعه مع الموت، فهو يُميت الموت، لا أن يموت بنفسه؛ لأنّ الإنسان ذائق للموت، لا مذوقه، وكلّ ذائق يهضم مذوقه دون العكس، إلّا أنّ الإنسان الكامل المعصوم× بما أنّه قد اجتاز الموت الإرادي في حياته، وقد تحرّر منه وحظى بحياة أفضل، فعند الموت الطبيعي سيدير ميدان الصراع مع الموت ويخرج منتصراً حتماً، ويهضمه على أحسن وجه؛ ولا سيّما إذا كان هكذا إنسان كامل معصوم يشرب كأس الشهادة إحياءً لدين الله والسنن الإلهيّة التي أُميتتْ. ولابدّ لهذا الانتصار في مثل هذا الصراع المجهد أجر عظيم، ألا وهو استقرار القرب الإلهي، والسعادة الدائمة، والتنعّم بالرزق الخاص، والمنزلة الإلهيّة العظيمة.
إنّ الزيارات المأثورة عن الأئمّة^ بحقّ سيّد الشهداء× هي جانب من فضائل ومناقب تلك الذات المقدّسة، وصحبه الكرام وشهداء كوثر كربلاء العظام، ومشتملة أيضاً على مقدار من تكاليف محبّي القرآن والعترة، ونذكر ـ من باب المثال ـ شيئاً مختصراً منها:
1ـ مَن حضروا كوثر كربلاء ـ لا سيّما سيّدهم ـ ، في الواقع هم ثار الله}، ومعنى ذلك أنّهم ضحّوا بدمهم في سبيل الله، والله تعالى وليّ دمائهم وهو الطالب بها. والسر في رقي هذه الدماء هو كمال التقوى والإخلاص الذي اتصف به هؤلاء الشهداء. فحينما يعدّ الله تعالى الذين يقدّمون قرابينهم بأنّه لا يناله منها إلّا التقوى كما في قوله: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)[45] إذن فلا محالة ينال الله التقوى من الشهداء الذين يضحّون بأنفسهم ودمائهم، و(النيل) في الآية الآنفة الذكر مفهوم أرقى من (الصعود) الذي ورد في قوله تعالى: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)[46].
2ـ إنّ أبدان الشهداء ـ ولا سيّما شهداء كوثر كربلاء ـ كانت طيّبة وطاهرة معنوياً، وهي منبع طيّب وطهارة وبركة الأرض التي رقدوا فيها: «طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم»[47]، ومن الواضح أنّ الأرض الطيّبة تُخرج ثماراً طيبة بإذن الله: (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ)[48]، وهذه الثمار الطيّبة التي أعطتها أشجار نمت في روضة طيّبة، هي عين العقل العلمي والعدل العملي، وهذا يعني أنّ بلاد الشهداء هي مهد الكمال الشامل.
3. الشهداء محفوفون بالرزق الطيّب؛ وذلك لأنّ بين يديهم مائدة واسعة: (بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...)[49] وخلفهم مأدبة حاضرة: «طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم»[50]. وهذا الاحتفاف من جميع الجوانب ببركة أُمنيتين، الأولى: إرادة الشهيد، والثانية: للسالكين على نهجه، أمّا الأمنية الأولى: فهي أُمنية الشهيد التي وردت في سورة (يس) حيث جاء: (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ)[51]، و(المكرمون) اصطلاح قرآني يراد به ملائكة ربّانيون، ولذا ورد في آية أُخرى: (بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ)[52]، وأمّا الأمنية الثانية: فهي أُمنية السالك لطريق الشهادة التي وردت في الزيارة: «يا ليتني كنت معك فأفوز فوزاً عظيماً»[53]، ولعلّ ما جاء في الزيارة الأولى لسيّد الشهداء× ناظر إلى هذا المعنى حيث ورد: «... أنا عبد الله... والوافد إليك، ألتمس بذلك كمال المنزلة عند الله ، وثبات القدم في الهجرة إليك»[54].
4ـ إنَّ شهداء كوثر كربلاء بإمامة أبي عبد الله الحسين× هم دعاة الأمّة الإسلامية والمجتمعات البشرية إلى الله تعالى على مناهج الأنبياء؛ ولذا ورد في الزيارة: «أشهد أنّك قد أقمت الصلاة... ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة»[55]، وبما أنّ الإمام× قد حظى بالقرب الإلهي، وبلغ كمال ذلك القرب بواسطة الفرائض والنوافل؛ لذا قد ورد في زيارته: «السلام عليك يا مَن رضاه من رضا الرحمن وسخطه من سخط الرحمن»[56].
5ـ إنَّ سيّد الشهداء× وارث جميع الأنبياء^ والأئمّة^ الذين سبقوه، وشاهد الصدق على ذلك صدر وسياق زيارة وارث، فرغم أنَّ كلّ إنسان كامل معصوم قد نال درجة الخلافة والفوز بالإمامة هو وارث لمن سبقه من المعصومين^، بيد أنّ ظهور تلك المواريث وبروز تلك الكمالات لم يكن مقدّراً للجميع.
وينبغي الانتباه إلى أنّ المعصومين الكمّل هم ورثة الكرامة والعلم الإلهي، ولا يتّبعون أحداً آخر، بل المرجع النهائي الذي يرجعون إليه باعتبارهم خلفاء الله، هو الميراث المستخلف عن الله الذي يوصله إلى خليفته، وجميع الأنبياء هم خلفاء الله، وإن أمكن ذكر أمر آخر بشأن الإمام×. فمن قوله تعالى (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ)[57]. يستفاد أنَّ النبي الاكرم’ يقتدي بهداية الأنبياء السابقين، لا يهتدي بهم أنفسهم، ولذا لم ترد الجملة هكذا (فبهم اقتده)، وبما أنَّ المعارف تأتي من مصدر واحد عن طريق الوحي، وتتمّ دعوة المجتمع البشري إليه، إذن فالمورَّث والمُورِّث لكلّ ذلك هو الله ، وأنّ سيّد الشهداء× هو الإمام المعصوم الكامل والكون الجامع، فهو حاوي لجميع كمالات المعصومين السابقين، وقد وهب الله} له جميع تلك الفضائل، وأنّ نصيب الصادر الأوّل أو الظاهر الأوّل أي: النبي الأعظم’ محفوظ في هذا التوريث.
6ـ إنَّ زائر كوثر كربلاء بعد أن يقدّم سلامه واحترامه يبلّغ سلام الله تعالى إلى أولئك الشهداء ولا سيّما سيّد الشهداء×، ويدلّ على هذا ما جاء في زيارة وارث: «عليكم منّي جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار»[58]، ويشهد على ذلك أيضاً ما ورد في زيارة أبي الفضل العباس× من إبلاغ سلام الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين وعباد الله الصالحين وجميع الشهداء والصدّيقين[59]. وبطبيعة الحال إنّ هذه المنزلة نالها الزائر ببركة المزور، وقد ورد في القرآن السلام من الله على الأنبياء والسائرين على نهج النبوّة والرسالة وخلافة الله : (سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)[60](سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)[61]. ويُفهم من ذلك أنّ المحسنيين ومن ينالون مقام الإحسان والذين يفوزون بالفيض كانوا محلاً للسلام من الله سبحانه.
7. الانتفاع من كوثر كربلاء له مظاهر، من أبرزها التولّي والتبرّي العملي والاعتقادي والسلوكي، ومن جملتها قوله في الزيارة: «يا أبا عبد الله إنّي سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة»[62]. ويستفاد من هذا الكلام أنّ الزائر الحسيني مجاهد في سبيل الله ومنزّه عن التساهل في الدين والتسامح في العقيدة، كما يستفاد من زيارة الجامعة الكبيرة أنّ المتّبع لأهل البيت^ مضافاً إلى اتصافه بالمناقب الآنفة الذكر هو من أهل التحقيق، يحقق ما حقق أهل البيت^، ويُعدّ ما أبطلوه باطلاً منقضياً، ويسعى إلى إبطال الباطل وإزهاقه، ونتيجة ذلك العلم والعقل والحكمة والعصمة من اللهو واللعب، وعبارة: «محقّق لِما حقّقتم ومبطل لِما أبطلتم»[63]، ناظرة إلى هذا الأمر، وكذا الجملة الغزيرة المضامين«محتمل لعلمكم»[64] الدالّة على طلب العلم المأثور عن تلك الذوات المقدّسة والموروث منهم، وقد وصفوا ذلك العلم بقولهم: «... لا يحتمله إلّا ملك مقرّب، أو نبي مرسل، أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان»[65].
إنّ زائر أهل بيت الوحي ـ لا سيّما كوثر كربلاء ـ طالب لعلم خاص وللحديث الصعب المستصعَب، وبعض أسرار عالم الوجود، على أمل أن يحظى المحبّون للقرآن والعترة وعلى الخصوص عشّاق كربلاء بهذا المقام الرفيع. ويستفاد من الشعار الأساسي للحسينيين: «وجعلَنا وإيّاكم من الطالبين لثأره»[66]، إنّ شيعة أهل البيت^ يطالبون بدماء مورِّثيهم؛ وذلك لأنّهم عندما آمنوا بنبوّة خاتم الرسل’ وإمامة الأئمّة الاثني عشر^ فقد لبّوا نداء النبي’: «أنا وعلي أبوا هذه الأمّة»[67]؛ ولذا فالشيعة يمتلكون الإجازة بذلك، بل إنّ الشيعة مأمورون بالمطالبة بدماء أبيهم المعنوي، وهذه المطالبة تصل إلى قمّة كمالها عند ظهور الطالب بدماء الأنبياء وأبنائهم، والمطالب بدم المقتول بكربلاء الإمام خاتم الأوصياء الغائب الحاضر المهدي# الموعود بقيّة الله (أرواح من سواه فداه)، وعند ذلك ينسى كلّ عاشق معشوقه، ويتّضح أنّ العقل الذي سُمّي بالمرشد لجميع العلوم غير مطّلع على نخب جوده وكرمه.
حال نه قال است كه گفتن توان – وجد نه نجد است که رفتن توان
خسرو توحید ندارد سریر – بلبل تحقیق ندارد صغیر
ای که از این چشمه نمی یافتی – کی طلبیدی که نمی یافتی
غیب نداند مگر أهل غيب – عيب نبينند به جز أهل عيب
زنده بود كشته شمشير دوست- مرده دل آن کس که نه مقتول اوست
گر بشکافی هنوز خاک شهیدان عشق- آید از آن کشتگان زمزمه دوست دوست
خاک کف راه نشینان نجد - بادیه پیمای بیابان وجد
منزل این ره نه تو دانی نه من - محمل این شه نه تو دانی نه من
نام نکو را چه فروشی به ننگ واینه چین چه فرستی به زنگ
ای شهید!
این چه بهار است که بر شاخ توست – وین چه نگار است که در کاج توست
صبح ازل تا به ابد یک دم است – فیض بقا تا به فنا یک نم است
مائده زنده دلان فائده است – فائده مرده دلان مائده است[68]
يا إلهي ما خرج من عقلي وقلبي وجرى على لساني وبناني من مسموع ومشهود، إنّما هو بلطفك وكرمك ومنّك انطلاقاً من قولك (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ)[69] وقولك: (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)[70] وقولك: (أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ)[71] ولا أملك شيءً كي أُهديه.
روي گرد آلود بر زی او که بر درگاه او آبروی خود بری گر آب روی خود بری[72]
إلهي أنا الفقير في فقري! اللهمّ زدني فقراً وفاقة إليك بمحمد وآله^.
الجوادي الآملي
آبان 1391ـ ذي الحجّة 1433
توطئة
يقع على عاتق المجتمع الإسلامي والأمّة الإسلاميّة بجميع أصنافها مسؤوليّة الحفاظ على النهضة العالميّة للحسين بن علي÷، والأمر لا يقتصر على المسؤوليّة فحسب، وإنّما عليهم تبليغ رسالة النهضة الحسينيّة، وهذه المهمّة لأعظم من مسؤوليّة الحفاظ عليها. والرسول: هو من يبلّغ الرسالة بأمانة كاملة إلى المرسل إليه؛ ويدركها جيّداً، وله ارتباط بالمرسِل والمرسَل إليه.
إنّ رسول كلّ إنسان يتناسب مع أفكاره ورؤاه، ولذا ينبغي مراعاة أمور في كتابة الرسالة:
أوّلاً: محاولة تحسين أسلوب ومحتوى الكتابة.
ثانياً: كتابة مسودّة ثمّ مبيضّة، ثمّ إعادة قراءتها من جديد؛ لأنّ رسالة كلّ إنسان ترجمان عقله: «رسولك ترجمان عقلك»[73]، بحيث يفهم من رسالة كلّ إنسان مكانته من الناحية العقلية.
وقد رأى الإمام الحسين× قابلية المجتمع الإسلامي واستعداده لحمل الرسالة فاختاره رسولاً له، إذن فالأمّة الإسلامية مكلّفة باستلام رسالته وإبلاغها وتنفيذها وتطبيقها في المجتمع الإسلامي وإيصالها إلى العالم.
إنّ لدى سيّد الشهداء× رسالة للإنسانيّة جمعاء، ولا تختصّ بالمليارات في العصر الحاضر، بل البشريّة من عصره إلى يوم القيامة، فالإمام الحسين× يعيش في كلّ زمان ومكان ويتحدّث بجميع اللغات.
وقد اختار الأمّة الإسلاميّة لأن تكون سفيراً ورسولاً له، ولم يجعلها وصيّاً، وقدّم لها ثمرة تضحياته؛ لتقوم هذه الأمّة بإيصال رسالة كربلاء إلى العالمين، ويجب على الحسينيّات ومواكب العزاء تهيئة الأجواء المناسبة لفهم هذه الرسالة وإيصالها.
بالرغم من عدم وجود فرق واضح بين الرسالة والوصاية في مصطلح النبوّة والإمامة، إلّا أنَّهما بحسب المرتكزات العرفية بين الناس يختلفان؛ إذ الوصاية يُشمّ منها رائحة موت الموصي، والوصي يباشر العمل بالوصية بعد موت الموصي، وأمّا الرسالة فيُشمّ منها عبق حياة المرسِل والرسول دون موتهما، إذن فالرسول مكلّف بأداء مسؤوليّة الرسالة أثناء حياة المُرسِل؛ لأنّ الشهيد في الثقافة الدينية ينعم بحياة أبديّة، والشهادة حياة معقولة جديدة، وأبو الأحرار سيّد الشهداء× يتنعّم بأعلى درجاتها، وعلى حدّ تعبير الخاجة الشيرازي: «لم يمت أبداً من كان قلبه بالعشق حيّاً»[74].
ويستنكر القرآن الكريم على مَن يظنّ أو يتوهّم أنّ الشهداء أموات، ويطلب إخراج هذا التوهّم من الذهن ويشدّد على أنّ الشهداء لا يموتون[75]، بل يتعدّى ذلك ويؤكّد حقيقة وهي أنّ الشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون[76]، ولديهم رسالة وفيها حياة الأمّة، وبناء على هذا فالإمام الحسين× حيّ أبداً، وأمره رسالة لا وصاية، فلا يُشمّ من كربلاء رائحة الموت أبداً، والإمام الحسين× لا يبعث رسالته من بين الموتى، بل يبعثها إلى الأمّة من بين الأحياء، فالعنصر المحوري في البحث الحالي هو: (رسالة المجتمع الإسلامي في النهضة الحسينية) لا وصايته×.
القرآن الحكيم يحدّثنا عن عزّة الإنسان ويسمه بالكرامة، حيث يقول: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)[77] وهذا فخر المجتمع البشري، وخلق الله} البشرية بالجمال والجلال والقبض والبسط، وبالملك والملكوت وبيدي الرحمة والقهر (خَلَقْتُ بِيَدَيَّ)[78]، والإنسان موجود جامع ومكرّم، وقد شارك الملائكة بهذه الصفات فإنّهم أيضاً عباد مكرمون: (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ بَرَرَةٍ)[79]، (...بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ)[80].
إنَّ دليل كرامة الإنسان خلافته، وهذا يعني أنّ قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ)[81] دليل قوله تعالى: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)[82]، والخليفة هو الذي يتحدّث بكلام المستخلَف عنه، ولهذا فمن يجلس على مائدة الكرامة ويتغذّى من خيرات الخلافة، ويأتي بكلام من عنده، فإنّ حياته غصبيّة ذليلة لا كريمة.
بعد أن يستلم الرسول أو رسول الله، أو رسول خليفة الله ورسول كربلاء، الرسالة بشكل صحيح، لا بدّ أن يمتلك انشراح صدر لجميع نواحي الرسالة وقدرة على البيان كي يتمكّن من بيان الحقّ للآخرين بأفضل شكل وإبلاغه للمجتمع، ولذا لمّا أصبح موسى الكليم رسولاً مكلّفاً بتبليغ الرسالة الإلهية إلى المجتمع آنذاك، طلب من الله تعالى قائلاً: (رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي)[83] كي لا يكون قليل التحمّل، ويدرك المعارف والأحكام المرسلة إليه جيّداً ويصدّق بها ويطبّقها على نفسه، ثمّ يبلّغها إلى الآخرين، فالرسول يحتاج في مشروعه الإرشادي إلى اللسان والقلم.
إنّ الذين يأنسون بالكتب العلمية ثلّة قليلة من الناس، والأكثر يأنسون بكلام المتكلّم؛ لذا لا بدّ من وجود الخطيب ليشرح لهم، ولذا تكلّم موسى الكليم مع الله} قائلاً: إنّي بحاجة إلى أن أُبسّط المعارف إلى المستوى الذي يفهمه عامّة الناس، وهذا الأمر يتطلّب بياناً واضحاً وعذباً وجذّاباً ولطيفاً، إنّ أخي هارون أفصح واعذب وألطف لساناً منّي: (وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا)[84] ويجذب السامعين بشكل أفضل، فاجعله شريكي في هذا الأمر: (وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي)[85] كي أتمكّن من إتمام هذه الرسالة بالشكل المطلوب. إنّ الله قد لبّى طلب موسى الكليم، فأفصح لسانه وشرح له صدره قائلاً: (قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى)[86] فاذهب أنت وأخوك إلى فرعون فوراً وامنعاه عن الطغيان: (اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى)[87] واسمعاه دعوة الحقّ ببيان هاروني.
يجب أن يكون الرسول مأموراً بالرسالة من قبل المُرسِل، وأن يعرف مُرسله ونهجه حقّ المعرفة ويؤمن به، ويلهج بكلام مرسله في حدود الرسالة، ولا يأتي بكلام من عنده، وعليه أن يحفظ علاقته مع المُرسِل حدوثاً وبقاء، وعليه فإذا درس مجتمعنا هذه العناصر الثلاثة، وعرفها جيّداً حينئذ سيكون رسولاً للإمام الحسين× ولكربلاء، وحينئذ يحقّ له أن يقول: «كلّ أرض كربلاء وكلّ يوم عاشوراء».
إنّ الله} قد قسّم المجتمع إلى طائفتين: الأولى: المسؤولين والثانية: الرعيّة، وعلى المسؤول أن يتحمّل مسؤولية القيادة عن علم ودراية، ويجب على الرعيّة أيضاً أن تكون على علم ودراية بالمسؤول والقائد، وأن لا تُسلّم نفسها لكلّ إنسان: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ * ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)[88] فمن أصبحت بيده قيادة المجتمع دون أن يكون له حظ من الوحي الإلهي، وأحاديث العترة الطاهرين^ والبراهين العقلية ستتحوّل قيادته هذه إلى ضلال للأمّة، كما هي عاقبة من يطيعون الشياطين جهلاً فطاعتهم ليست إلّا الضلال المبين: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ)[89]، فالطائفة الأولى قادة مضلِّون والطائفة الثانية أتباع ضالّون.
فكلّما ارتبطت هاتان الطائفتان وتحلّى كلّ من المسؤولين والناس بالعلم والعقل والوعي حينها سيكونون قادرين على إنشاء علاقة معقولة مع أهل بيت العصمة والطهارة^؛ لأنّ العترة الطاهرين هم مصدر العلم والعقل ومؤسّسو الشرع والدين، فإذا الأمّة لم تتفرّق، وارتبطت بالعلم والعقل والحكمة ستحظى بدين طيّب طاهر، وتصبح مؤهّلة لإبلاغ رسالة سيّد الشهداء×، وإن قام أحد بعمل سفيه أو عمل عملاً بسفاهة، ولم يتقدّم خطوة عن حكمة، فإنّه سينفصل عن إبراهيم الخليل×، وبالتالي لا ينتمي إلى أيّ أحد من الأنبياء والمعصومين^ بعده.
إنّ الله سبحانه وتعالى قد أعطى لإبراهيم رشده: (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ)[90]، وقد كسر الأصنام بفأسه، ومن لا يختار الطريق الحقّ الذي سلكه الخليل أو ابتعد عنه فهو سفيه، وقد عمل عملاً سفهياً: (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)[91]؛ وذلك لأنّ منطق إبراهيم العلمي ومنهجه العملي قائمان على أساس العقل والعلم والحكمة. وبناء على هذا فإنّ من أهمّ العوامل التي تربط المجتمع بالأنبياء العقل والعدل والعلم والوعي الرفيع، والضرورة الوحيانية والعقلانية، والمجتمع الذي يتحلّى بهذه الخصوصيات يستطيع أن يصبح رسول الأئمّة^ ويبلّغ رسالتهم إلى المجتمعات الأخرى، بل يمكنه أن يصبح أباً لها؛ وذلك لأنّ النبي الاكرم’ قال: «أنا وعلي أبوا هذه الأمّة»[92]، وهذه هي رسالة كربلاء، ويُعلم ممّا تقدّم أنّ ما يربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض ويجعلهم منتمين إلى طه وياسين عنصران محوريان:
1ـ رجاحة عقول القادة الدينيين وعدلهم.
2ـ علم الرعيّة المسلمة وطاعتها.
والعلم ـ أيضاً ـ أمرٌ مشترك بين الطائفتين، فعلى المسؤولين أن لايقودوا المجتمع إلّا على أساس العلم، وعلى الرعيّة أن لا يختاروا قائداً إلّا على أساس العلم.
يحتلّ العلم والثقافة في عمليّة الدعوة المرتبة الأولى، والعصا والسيف في المرتبة التالية، بالرغم من ضرورتهما معاً في الوصول إلى الهدف، كما قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)[93].
البيان والموعظة وحضور المسجد، وصلاة الجمعة والجماعة، والحسينية، ومجلس العزاء والمحاضرة والكتاب شيء، والقوّة والسلاح والأجهزة التنفيذية شيء آخر، بمعنى أنّها لو لم تتوفّر، فإنّ الأجانب سيُلحقون الضرر بالبلادوبناء على هذا فأوّلاً لا بدّ من الاستدلال والبرهان وإقامة الدليل والتوضيح، وإذا لم ينفع يأتي دور العصا التي قد تتحوّل إلى ثعبان[94]، وهذا ما يؤكّد عليه القرآن الكريم، حينما تحدّث عن إرسال الرسل والكتب السماويّة: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) ثمّ قال: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ)[95]، فالقرآن لم يطرح في البداية موضوع إنزال الحديد، بل طرح أوّلاً الإمامة والحديث عن الوحي والتعليم والتزكية والتثقيف، ثمّ يأتي دور إنزال الحديد الذي فيه بأس شديد في المرتبة المتأخّرة.
4 ـ دائرة رسالة الأمّة الإسلاميّة
لا تقف حدود رسالة الإمام الحسين× عند مجتمع ما، فهي تشمل جميع المجتمعات الإسلاميّة، فالإمام الحسين× من خلال التضحية بدمه الطاهر يخاطب جميع المسلمين موصياً إياهم بأن لاتظلموا ولا تسكتوا على ظلم، واعلموا أنّكم في بناء حقّ رصين، أي تتنشقون هواء وتعيشون على أرض و تحت سماء جميع عناصرها حقّة:( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ)[96].
الكلام الآخر المبيّن لسعة مجال الولاية والرسالة، ما جاء في وصيّة أميرالمؤمنين× علي بن أبي طالب× حيث قال: «أُصيكما وجميع ولدي وأهلي ومَن بلغه كتابي»[97]، ومعناه أنّ وصيّته لا تقتصر على الحسن والحسين والعباس وبقيّة بني هاشم، بل هي شاملة لجميع من وصلته الوصيّة، فهم أوصياء الإمام× منذ صدورها إلى يوم القيامة، وبناء على هذا الأساس قال الإمام علي× فيما يتعلّق بالمرأة المعاهِدة التي هُتك سترها ولم ينصرها أحد: «فلو أنّ مؤمناً مات من دون هذا أسفاً ما كان عندي ملوماً»[98]؛ لأنّ الإمام× يرى أنّ الرجل والمرأة اليهودية المعاهِدة تحت رعاية الحكومة الإسلاميّة، وإذا أرادت جماعة سلب الدين والعقيدة والمبادئ والقيم من المجتمع بأعمال ظالمة جاهلة فهذا يسبّب قلقاً كثيراً.
إنّ جوهر الدين والعقيدة والشريعة هو الشرف والكرامة وحياة الدنيا والآخرة، وأمّا الأمور الماديّة كالذهب والفضّة وأشباهها لها قيمة اقتصادية، ولكنّ الثقافة العلوية لا ترى لها قيمة كي تقاس بجوهرة الدين، ولذا أمر الإمام× المسؤول المالي الخاص به أن يعطي السائل ألف مثقال، فقال المسؤول المالي: أُعطيه ألف مثقال من الفضّة أو الذهب؟ فقال الإمام×: «كلاهما عندي حجران فاعط الأعرابي أنفعهما له»[99] نعم، إنّ كلّ من الذهب والفضة عند الإمام علي× حجران لا يختلفان إلّا من حيث اللون.
إنّ الإمام الحسين× قد تربّى على يد النبي الأكرم’ وترعرع في أحضان علي× ودائرة رسالته شاملة لكلّ المجتمعات الإسلاميّة، وهذه هي رسالته ذات المسؤوليّة الكبيرة.
لم تکن النهضة الحسينية قضية شخصية، وإنّما هي حركة فكريّة تاريخية وسنّة إلهيّة، وبالتأكيد تحمل رسالة؛ لأنّ السنّة الإلهيّة شاملة لجميع الأجيال والأعصار والأقطار، ولذا يلزم تحليل حادثة كربلاء والأخذ بنظر الاعتبار الأحداث التي حصلت قبلها وبعدها، ولا بدّ من دراسة المخالفين وتحليل أعمالهم التي قاموا بها قبل ثورة الإمام الحسين×، وأوامرهم التي أصدروها بشأن حادثة عاشوراء، والإجراءات التي اتخذوها بعد الحادثة كي يتمّ فضح نواياهم الخبيثة لإبادة الإسلام.
جدير بالذكر أنّ أفضل طريقة لاستلهام رسالة نهضة كربلاء هي تحليل نفس كلام سيّد الشهداء×، كما أنّ شعاع كلّ رسالة منوط بالشعاع الوجودي لمرسلها، ورسالة النهضة الحسينية قد اجتازت دائرة التوحيد، بل تعدّت ذلك لتشمل بخطابها كلّ إنسان (أعم من الموحّد والملحد)؛ لأنّ إمامة الحسين× لا تختصّ بالشيعة كي تكون رسالته محدودة بعالم التشيّع فحسب، فالإمام بما هو وليّ أمر المسلمين تكون دائرة رسالته شاملة لكلّ أرض يسكنها المسلمون، وبما هو قدوة الموحّدين، فتشمل رسالته جميع الموحّدين، وبما أنَّ الإمام هو الإنسان الكامل وخليفة الله في أرضه، فدائرة رسالته تشمل جميع الإنسانية على اختلاف لغاتها وبقاعها.
ولنهضة عاشوراء مراتب، فهي تخاطب عامّة الناس والخواص والأوحدي من العلماء والمفكّرين؛ لأنّ الناس ليسوا سواء، فمنهم: المعصوم الذي يرى القيامة، ويرى الجنة، وينظر إلى البرزخ، ويعرف أهل الجنّة، ومن في البرزخ، وينادي: «لو كُشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً»[100]، ومنهم: من يرى الجنّة وأهلها، والنار وأهلها: «فهم والجنّة كمن قد رآها فهم فيها منعّمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذّبون»[101] وجماعة أخرى لم تحظى بأيّ من هذه المراتب، لكن لهم آذان تسمع رنين جرس قافلة أهل الجنّة.
کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست ـ این قدر هست که بانگ جرسی می آید[102]
وفئة لا يسمعون حتّى رنين جرس هذه القافلة، ويتصوّرون أنّ الإنسان يفنى بالموت، فهؤلاء مصابون بعمى البصيرة، يظنّون أنّ الله أنعم عليهم حينما لم يلتحقوا بالجبهة حتّى لا يُقتلوا، وقد قالها قبلهم من أُصيب بعمى البصيرة ـ أيضاً ـ في صدر الإسلام: (...قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا)[103].
وبناء على هذا فالنهضة الحسينية ذات خطابات متعدّدة تتناسب والفئة المخاطبة، ولم يكن خطابها للجميع بمستوى واحد[104]، والنتيجة:
1ـ نهضة سيّد الشهداء× تحمل رسالة لجميع الناس.
2ـ درجات معرفة الناس وثقافتهم غير متساوية.
3ـ مراتب الخطاب لن تكون متماثلة.
الكأس الأول: العطاء المعرفي لكربلاء
الجرعة الأولى: معرفة مكانة الإمامة
إنّ رسول الله’ قد جعل العترة الطاهرة عدل القرآن الكريم، وبناء على هذا فأهل البيت( لا يمكن قياسهم بعامّة الناس: «لا يقاس بنا أحد»[105] وقال أمير المؤمنين× أيضاً: «لا يقاس بآل محمد’ من هذه الأمّة أحد»[106] وهذه الجملة نكرة في سياق النفي وتعني أنّه لا يوجد أحد على وجه الأرض يكون عدلاً لأهل البيت^؛ لأنّ جميع أهل الأرض لم يرتشفوا من رحيق مدرسة الوحي حتّى يمكنهم القول: «ينحدر عنّي السيل»[107] «وسلوني قبل أن تفقدوني»[108] وكما أشارت الزيارة الجامعة الكبيرة إلى أنّهم كانوا أنواراً محدقين بالعرش، ثمّ تنزّلوا إلى هذا الخلق[109] تجلّياً، فيجب أن يقاسوا بالقرآن لا بغيرهم.
نعم إنّ حكومة أمير المؤمنين علي× على الروم وإيران والحجاز والشرق الأوسط بأسره وجميع العالم الإسلامي كانت مصحوبة بحياة بسيطة، وخلال تفقّده حوائج الفقراء يخاطب العسل: «لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل»، وهذا لا يعدّ من مراتبه الولائية البارزة، بل هو كثمالة كأس الولاية، أمّا صافي كأس الولاية وخالصه فهو أمرٌ آخر، كعلمه بالغيب ومعرفته بطرق السماء أكثر من علمه بطرق الأرض، وتعليمه الملائكة، وعدم عبادته لربّ لم يره، وسماعه لما يسمعه النبي الأكرم’، ولذا قال له رسول الله|: «إنّك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلّا أنّك لست بنبي»[110].
إنّ معرفة الولاية وتحمّلها يحتاج إلى أن يكون الإنسان كالجبل، والجبل إذا أراد أن يتحمّل الولاية تهاوى، وقد أشار إلى هذا الإمام أمير المؤمنين× بقوله: «لو أحبّني جبل لتهافت»[111]. وقد قال السيّد الرضي في تفسير ذلك: «معنى ذلك أنّ المحنة تغلظ عليه فتُسرع المصائب إليه، ولا يُفعل ذلك إلّا بالأتقياء الأبرار والمصطفين الأخيار»[112]، ولكن معنى عبارة الإمام× أعمق من ذلك بكثير، ولا بدّ من تفسيرها كما ورد في الآية: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)[113] كذلك حقيقة ولايته× هي عدل القرآن، حيث ندعوكم إلى التوحيد الحقيقي، ولو عُرضت ولايتنا ومحبّتنا، وحقيقتنا النورانية على الجبل لتهافت[114].
الإمامة عند الشيعة مسألة كلاميّة لا فقهيّة محضة، والإيمان بها لا يقتصر على الاعتقاد بوجوبها فحسب، بل يتعدّى إلى وجوب الاعتقاد بأنّ الإمام× يُنصّب ويُعيّن من قبل الله تعالى بشكل مباشر.
توضيح ذلك: للإنسان ارتباط وثيق بهذا العالم ككل، وهو شاء أم أبى لا بدّ أن يخوض غمار هذا العالم، لكنّه غافل عن أسرار كثيرة في هذا العالم بدءً من أعماق البحار وانتهاءً بذرى المجرّات، ولا يعلم إلى أين سيكون مصيره بعد زوال هذا العالم، كما أنّه يجهل ما يراد منه هنا وما سيراد منه، ولا يعلم كيف يُؤمّن المتاع الأبدي الخالد، وهذا ما يكشف عن حاجة إلى قائد ملكوتي كي يتمكّن من تأمين جميع هذه الأمور.
إنّ الإمامة من أصول المذهب، لكن التوحيد والنبوة من أصول الدين، فالإمامة مسألة كلاميّة وليست فقهيّة؛ وذلك لأنّ المسألة التي يكون موضوعها فعل الله تعالى لا تدخل في علم الفقه والقانون والأخلاق، بل محلّها الرفيع هو علم الحكمة والكلام، وهذا بخلاف المسائل التي يكون موضوعها أفعال الناس حيث أنّ محلّها علم الفقه والقانون والأخلاق.
وليس الكلام حول مجرّد قتل مظلوم في كربلاء، أو استشهاد طالب للحرّية، أو قتل بريء أو ضيف، وبالرغم من وجود كلّ ذلك، لكن أيّ من هذه الأمور لا يمكنه أن يخلّد كربلاء؛ لأنّ نظائر هذه الأمور قد جرت على كثير من البشر، ومع ذلك أكل الدهر عليها وشرب، إذن ينبغي أن نبحث في كلام الإمام الحسين× وخطابه يوم عاشوراء كي نعرف السر في خلود كربلاء وتميّزها عن بقيّة الوقائع والأحداث، فمن كان مكانه العرش لاينبغي بقاؤه في الأرض.
وإذا أردنا أن نتعرّف على منزلة الإمامة ومنطق الإمام الحسين× ونعلم من أين يستق الأئمّة^ رسالتهم، وإلى أيّ شيء يدعوننا، فلا بدّ من الرجوع إلى محكمة القرآن الكريم، فإنّه يتضمّن أسراراً غزيرة حول أبطال العالم، وفرسان الحروب، والأحرار، وطلّاب العدالة، ورجال نهضوا وسُقوا كأس الشهادة من أجل تحقيق الرفاهية في المجتمع. ولكن لا يمكن أن يقاس سيّد الشهداء× بأحد من هؤلاء؛ لأنّهم جميعاً يستضيئون بشعاع من أشعّة النهضة الحسينية، وأمّا منشأ ومنبع إمامة أهل البيت^ وزعامتهم فشأن آخر، وسيّد الشهداء× هو الخليفة الكامل للذات المقدّسة، وزعامته للأمّة قائمة على أساس التنصيب الإلهي، لا انتخاب الناس، إذ إنّ منتخب الناس وكيلهم، والمُنصّب من قبل الله وليّهم، فالأئمّة× إنّما دخلوا إلى الميدان بواسطة قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ...)[115]، وقوله الله : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ...)[116] وقوله تعالى: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ...)[117] والمقارنة لا بدّ أن تتمّ على هذا المستوى.
طبقاً لقول الإمام الحسين×: «اشتدّ غضب الله تعالى على اليهود إذ جعلوا له ولداً، واشتدّ عضب الله على النصارى إذ جعلوه ثالث ثلاثة...، واشتدّ غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيّهم»[118] تعدّ الإمامة من الأصول ومعنى هذا القول أنّ بعض الأمم قد ارتكبت جريمتين تاريخيتين كبيرتين واشتدّ غضب الله عليها نتيجتهما، والجريمة التاريخية الثالثة أنتم على مشارف ارتكابها، وسيشتدّ غضب الله عليكم، فأمّا اليهود فاشتدّ غضب الله عليهم لاعتقادهم أنّ لله ولداً، حيث يرون ـ والعياذ بالله ـ أنّ عزيراً ابن الله تعالى، وأمّا النصارى فقد اشتدّ غضب الله تعالى عليهم بسبب قولهم إنّ الله ثالث ثلاثة[119].
وعليه فقد اشتدّ الغضب الإلهي على اليهود لما وقع في توحيدهم من انحراف علمي؛ لأنّهم قد ابتُلوا بمشكلة التثنية، واشتدّ الغضب الإلهي على النصارى أيضاً؛ لأنّهم ابتُلوا بالتثليث، وأنتم (يا من تدّعون الإسلام) قد ابتُليتم بمشكلة الإمامة؛ لأنّكم تريدون قتلي، وقتل الإمام المعصوم يعني إنكار الإمامة ونسف لأهم أصل عقائدي، وهذا الكلام من الوحي الالهي، ومعناه أنّ حربي لكم سوف لا تكون حرباً اعتيادية؛ لأنّي لست قائداً لدعاة الحرّية وطلّاب العدالة والاقتصاد كبقيّة القادة، حتّى يقال ما أكثر قادة الحرّية في العالم؛ وذلك لأنّنا ـ أهل البيت^ ـ جئنا من نشأة ونذهب إلى نشأة أخرى، محاولة منّا لإيصال رسالة تلك النشأة إليكم، ونطلعكم على ذلك العالم، ونوصل صوت الرسول الباطني ـ الذي لا تسمعونه ـ إلى مسامعكم، ونُعرّفكم العالم الأبدي، الذي نُخبركم عنه حينما تتوقّف حركة الكون والظواهر الطبيعيّة وتطوى الأرضون والسماوات والمجرّات، وتبقى حقيقة الإنسان المجرّدة الثابتة، المعانقة للأبديّة، فالفرق بيننا وبين غيرنا من القادة، أنّنا نحمل لواء التوحيد، وندعوكم إليه، وننهض للمحافظة عليه.
ويريد الإمام الحسين× إيصال رسالته بضرورة الاعتقاد بالإمامة إلى جانب التوحيد الإلهي، ويعلمهم بأنّ غضب الله عند قتله يماثل غضبه على اليهود والنصارى، وأنّ قتله كتثليث النصارى، وتثنية اليهود، وثنوية المجوس، وينبّههم إلى نتيجة قتله وهي الكفر. فمن خالف الإمام قد ارتكب معصية كبيرة، ومن خرج عليه محارباً فهو كافر، كما قال النبي الأكرم| لعلي×: «حربك حربي وسلمك سلمي»[120].
بناء على هذا فإنّ سيّد الشهداء× قد عدَّ الإمامة ضمن المسائل الكلامية وعدَّ احترام العصمة الكبرى وحجّة الله البالغة على حد احترام التوحيد، ومن هنا أوضح الإمام الحسين× عظمة نهضة كربلاء، وقد جعل على عاتق الأمّة الإسلامية رسالة مهمّة من خلال شعاره: «هل من ناصر ينصرني وهل من ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله»[121].
قد أُفرد في كتاب أصول الكافي باباً تحت عنوان «الإمامة عهد من الله»[122] وتمّ الاستناد في هذا العنوان إلى الآية المباركة (قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[123]، والباب مشتمل على روايات كثيرة تركّز على أنّ الإمامة ليست بالانتخاب؛ وذلك لأنّ آراء الناس وانتخاباتهم تكشف عن قبولهم للإمامة فقط ولا تدلّ على إنشائها، فالناس لهم حقّ التولّي لا التوكيل، فهم لا يعطون الوكالة إلى الإمام المنصّب من قبل الله وإنّما يقبلون ولايته.
والوكيل يستمدّ قوّته من الموكِّل، فالموكِّل الذي لديه القدرة على الإتيان بالعمل من الناحية القانونية بإمكانه إحالة ذلك العمل إلى الوكيل، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه على الإمام والإمامة من قبل الناس؛ لأنّ النظام الإسلامي فيه مجموعة من الأمور خارجة عن قدرة عامّة الناس فلا يمكنهم توكيل أمرها إلى ممثّليهم، وعلى سبيل المثال: حاجة المجتمع إلى إنسان صالح يحكم بدخول الشهر إذا ثبت عنده، ويرفع بذلك الحيرة عن ملايين الناس، وكذا تعيين الحدود وإقامتها، وغيرها من الأمور التي ليست تحت قدرة عامّة الناس حتّى يُفوِّضوا أمرها للقائد.
ولذا فالناس ليس لديهم حقّ إبداء الرأي في ولاية الإمام، ولا في توكيله، وبعبارة أُخرى: الإمّة ليست موكِّلة، بل يُتولَّى أمرها، ووظيفتها أن تتولّى لا أن تجعل الولاية للإمام والقائد.
ومن هنا يتّضح الفرق بين (الديمقراطيّة الصرفة) وبين (الديمقراطيّة الدينيّة)، فالديمقراطيّة المحضة الشائعة اليوم في العالم يقوم فيها الناس باختيار من يُمثّلهم بكلّ حرّية، ليتسلّموا مناصب مختلفة سياسية واجتماعيّة، ثمّ يحاول المنتخَبون فهم رغبات وعصارة أفكار الناس والعمل على تحقيقها، وأمّا الديمقراطية الدينية: فالمجتمع يدار فيها على أساس الوحي والنظرية القرآنية، بناء على اعتقاد أفراده بأنّ الإنسان والعالم مخلوقان لله تعالى، والوحي والأنبياء مكلّفون بإيصال وبيان رسالة الله إلى الخلق، وأنّ الموت ليس فناء (وتآكل وتلاشي) وإنّما هو (الخروج من الصدفة أو الشرنقة) الانتقال من عالم إلى عالم آخر، فالموت هو رفرفة طائر الروح وخروجه من قيود البدن، وليس الموت انطفاء نور الحياة، وإنّما هو ولادة جديدة ومن خلاله يسهل اللقاء بالحبيب، وأنّ هناك أموراً بعد الموت، ولا ينبغي الذهاب إلى هناك بوجوه سوداء وأيدي خالية، بل يجب السعي من أجل حياة هادئة كريمة لاتقبل ذلّ المتسلّطين في الدنيا، وتنال السعادة ـ أيضاً ـ بعد الموت. وهذه المعتقدات لايمكن العثور عليها ـ أبداً ـ في المذاهب والديانات الإنسانية، والحصول عليها ينحصر في مصدرها الوحيد، وهو الله تعالى الذي خلق الدنيا، وخلق الإنسان فوهبه جسماً يُفنى وروحاً تبقى لا تموت، وهو يعلم من أين بدأت رحلة الإنسان وإلى أين تنتهي، وهو العالم بما ينفعه من متاع وزاد في هذا الطريق.
وبهذه البنى التحتيّة العقائديّة لا يبقى أمامنا إلّا انتخاب المسلم المتديّن والذي يكون من ذوي الاختصاص في العلوم الإسلامية كالفقه والأصول و... والمبارز للأجانب والحذر من بيع أسرار الناس والدولة، ومن يهتمّ بمطالب الأمّة، ويُدرك جيداً قناعات المجتمع الديني ومعتقداته ويطبّقها عملياً.
وقد أوضح أمير المؤمنين× الطريق الذي بيّنه القرآن الكريم، وكان يؤكّد على الذين نقضوا العهد بانّ عهد الإمامة عهد من الله قد أكرمنا به، فلسنا بطّلاب سلطة أو منصب، ولكنّكم لم ترضوا بذلك وأنكرتم، وإنّي أبلّغكم بذلك إتماماً للحجّة عليكم لا غير، وبعد العزلة الطويلة جئتموني وطلبتم رأيي ودعوتموني لذلك[124].
وقد كتب سيّد الشهداء× كتاباً إلى وجهاء أهل الكوفة والبصرة، مضمونه: أنّكم بعد الانزواء التاريخي أرسلتم كتباً كثيرة تطلبون فيها منّي أن أدخل إلى الميدان السياسي؛ ألا فاعلموا أنّ الإمامة عهد إلهي من قبل الله تعالى، فعليكم بالصبر والشكر؛ وإنّي باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل[125].
نعم الإمامة عهد إلهي وتنصيبي، وتوضيح ذلك: إنّ الجنّة وعالم البرزخ لا يُرى فيه أعشاب ضارة، وأمّا عالم الطبيعة لا مناص من الأعشاب الضارّة فيه؛ وذلك لأنّ هذا العالم عالم الحركة والاختبار، ولا يمكن معرفة الحقّ من دون وجود الباطل، ولو لم يظهر الباطل في عالم الطبيعة لكان امتحان البشر سهلاً، بل لا معنى له، وبناء على هذا فوجود حلقات الباطل ضروري بالغير؛ لأنّ الدنيا نشأة امتحان واختبار، والأمور الباطلة كالأعشاب الضارّة ينفر بعضها من بعض ولا تتكوّن فيما بينها أيّ علاقة، بخلاف سلسلة الأنبياء التي يتّصل مكوِّنوها أحدههم بالآخر، يشتركون جميعهم في دعوة الإنسان إلى مبدأ واحد، ولسان حالهم يقول: (إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ)[126] وبهم أصبح أهل الإيمان «يداً واحدة على مَن سواهم» ولكن الطغاة كلّ منهم يدعو المجتمع إلى نفسه، ولذا ينفر بعضهم من بعض، فيتفاخرون ويتكبّرون للحظات، ثمّ يخفت كبرياؤهم كالزبد يعلو الماء ويذهب جفاء.
فنهضة سيّد الشهداء× متّصلة بنهضة الأئمّة والأنبياء السابقين، وهذا ما يضفي على تعيين الإمام وتنصيبه أهمّية بالغة؛ لأنّه متى ما تمّ تعيين الله للإمام وتنصيبه إماماً معصوماً ووليّاً لله وقائداً للأمّة اكتمل الدين ويئس أعداؤه[127]، لذلك فإنّ القرآن لم يتطرّق إلى إكمال الدين ويأس الكافرين حينما نزلت آية التطهير، وآيات الإمامة العامّة والأوصاف العامّة للأنبياء؛ وذلك لأنّه لم يكن هناك تصريح أو إعلان عن تنصيب قائد معيّن، بالرغم من أنّ منزلة العصمة والطهارة والولاية من أبرز درجات الإنسان الكامل؛ لأنّ مَن خان الله ورسوله| ومَن يتربّص الفرصة سرعان ما يطبّق تلك الأوصاف العامّة على نفسه، ويقول: «منّا أمير ومنكم أمير»[128]، وقد قام الوضّاعون للحديث بجعل تلك الأوصاف للأُمويين والعباسيين، وجعلوهم معصومين وطاهرين بتفسير الأحلام وأمثاله، إلّا أنّ الذين كانوا يزعمون بأنّهم قادرون على أن يصبحوا أئمّة للمسلمين ـ ولو بالمغالطات ـ سيُصابون باليأس في يوم الغدير الذي فيه يتمّ تطبيق تلك الصفات العامّة والمعلومات الكلّية على شخص معيّن، ويصابون بالقنوط عندما يتمّ تعيين علي بن أبي طالب× وليّاً لله وإماماً معصوماً مصوناً من الذنب والسهو والنسيان ويقدّم للأمّة: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)[129]، (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ)[130].
عند تعيين وتنصيب الإمام المعصوم× يقول الله تعالى: (فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ)[131] ودافعوا للحفاظ عن هذا الدين الكامل، ومن يخاف الله هو الذي يستطيع أن يدافع عن هذا الدين، وأمّا المتهوّرون الذين لا يخافون لا من الله ولا من الخلق فبالرغم من كفائتهم في المبارزة إلّا أنّ حربهم دنيويّة فاشلة لا تثمر؛ لأنّهم لا يفكّرون في الدعوة إلى القسط والعدل وشعارهم: (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى)[132]، وأمّا ضعفاء الإيمان من المسلمين، والمتفرّجون الذين يخافون الله ونار جهنّم ويخافون ـ أيضاً ـ من سيف الظالم، فهؤلاء لا يصلون إلى بغيتهم وهدفهم أبداً؛ لأنّ من لا يكون موحّداً في الخوف لا يكون موحّداً في الرجاء، والنتيجة أنّه غير موحّد في العقل الذي يدير كلتا الصفتين، وقوله تعالى: (فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ) ناظر إلى الخوف التوحيدي.
إنّ من يخاف الله تعالى لا يتساهل في أداء تكاليفه ووظائفه، بل يجاهد ويسعى على أيّ حال في عصر سقوط نظام الباطل أو في عصر إقامة نظام الحقّ، ولذا وجب الخوف من الله سبحانه، وحرم الخوف من الآخرين وترك الأحكام الإلهيّة، أي أنّ الله} قد أمر بواحدة وهي الخوف من الله، وقد نهى عن أخرى وهي (الخوف من الباطل غير الله).
إنّ معاوية بعد الصلح الذي اضطرّ إليه الإمام الحسن× حاول تبديل الخلافة والإمامة إلى ملك عضوض، وخير شاهد ما فعله عمرو بن العاص حينما دخل على معاوية في قصره أثناء أحد مجالسه الرسميّة، لم يستعمل لفظة الخليفة في سلامه وإنّما قال: «السلام عليك أيّها الملك»[133] فقال معاوية: لم يكن صراعنا على الصلاة والصوم، وإنّما حاربنا من أجل الإمامة[134] أي أنّ معاوية غصب اللبنة الأخيرة التي بها اكتمل الإسلام. ومن الواضح أنّ من لا يكون قائده إلهيّاً فلا يُعير أيّ اهتمام لصلاة الناس ولا لصيامهم، فقد سعى بنو أُميّة جهدهم في تحويل الخلافة والإمامة إلى ملك وسلطة، وعلى إثر ذلك تصبح النبوّة والرسالة مسؤوليّة عاديّة وتحلّ الوثنية بدل التوحيد والربوبيّة والألوهيّة، ووصل بهم الأمر في نهاية المطاف إلى أن يصرّحوا علناً:
|
لعبت
هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل[135]. |
فلكي لا تتفكّك هذه الحلقات بيد الأمويين والمتظاهرين بالدين كشريح القاضي أرسل الإمام الحسين× مسلم بن عقيل إلى الكوفة، وعمد إلى كشف الستار بكتبه وكلماته وخطاباته عن خداع الأمويين وحيلهم حيث اتخذوا الإسلام الأموي غطاء للقضاء على الإسلام المحمّدي الأصيل[136]، وإلّا فهو ليس بحاجة إلى مساعدة أهل الكوفة، وهذا ما يُفسّر عدم تذمّره وشكواه لما أُخبر بقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، وسحب جثّتيهما في أزقّة الكوفة، ومبايعة الناس لابن زياد، بل وضّح الأمور وأقام الحجّة، وتوجّه نحو الكوفة واثقاً بأنّه في توجّهه هذا نحو العراق سينال الشهادة، وأنّ ثورة الكوفة لا تجدي له نفعاً[137] فأقبل يقول:
«إنّ هذه الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت، وأدبر معروفها واستمرّت حتّى لم يبق منها إلّا كصبابة الإناء، وإلّا خسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحقّ لا يُعمل به، والباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برما»[138].
رسالة المجتمع الإسلامي هي معرفة عِدل القرآن الكريم، أي: الإمام المعصوم، والإيمان به، والعمل بمقتضى عقيدته، ونشر علومه ومعارفه؛ لأنّ الإنسان الكامل مظهر الله} وله عيال كثير يتغذون من مائدته، ومن هنا تصبح دائرة مسؤوليّة رسول الله’ (كَافَّةً لِلنَّاسِ)[139]، و(رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)[140]، واسعة فيرى الجميع أبناؤه، وكلّ أب مسؤول عن تغذية أبنائه، فقد قال’: «أنا وعلي أبوا هذه الأُمّة»[141]، ولا محالة أن يتّصف الإمام الحسين× بهذه المنزلة، ويحمل على عاتقه هذه المسؤولية.
نعم، إنّ الناس يحملون هوية اعتيادية لا تؤدّي إلى الوهن ولا تبعث على الفخر، وانتخاب تلك الهوية ليس بأيديهم، فهم مضطرّون على الولادة من أب وأٌمّ معيّنين، ولكنّهم حينما يكبرون ويعقلون يصبح اختيار الأب وتعيين الهوية بعهدتهم، وتتطابق هويّتهم الخاصّة مع شخصيّتهم.
وقد أعلن النبي الأكرم| وعلي بن أبي طالب× عن استعدادهما لتبنّي الأمّة الإسلامية، فالأمّة الإسلامية أُسرتهما، فكما أنّ بيديهما إدارة عالم الملك والملكوت بإذن الله كذلك إدارة المجتمع الإسلامي وحراسته والمحافظة عليه والشفاعة له وحلّ مشاكله.
فهذا الإنسان وإن لم يكن سيّداً من حيث النسب إلّا أنّه يحمل كرامة الانتساب إلى أهل بيت الوحي كما في قوله×: (منّا أهل البيت)[142] التي قيلت بحقّ سلمان وبحقّ الكثير من المتّقين رجالاً ونساء[143] ولكن الرواية التي وردت بشأن سلمان أكثر شهرة.
وقد ورد عن الإمام الصادق× السبب في عدّ سلمان أو أيّ أحد من المؤمنين من أهل البيت، حيث ذكر أنّ السبب في ذلك قول الله : (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ)[144] وقول الله} على لسان نبيّه إبراهيم×: (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي)[145][146] وهذا يعني أنّ كلّ من يتّبع علوم الوحي وتعاليمه فهو أحد أعضاء أُسرتنا وأهل بيتنا، بل إن عاش حياته بعقل وحكمة فلا يقتصر الأمر على أن يكون ذلك المتّبع ابناً لعلي بن أبي طالب× وابناً لرسول الله|، بل تكون لديه شجرة نَسَبيّة طويلة، فيكون ابن عيسى وابن موسى وإبراهيم: (مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ...)[147] ومعنى هذا أنّ عليكم سلوك طريق أبيكم إبراهيم؛ لأنّ لكم أصلاً ونسباً وشجرة طيبة وطاهرة، فلماذا تتركون طريق آبائكم، وتسلكون طريق الغرباء، والحال أنَّ إبراهيم أبوكم وقد تبنّاكم.
إنّ كلمة (ملة) منصوبة بالإغراء يعني خذوا ملّة أبيكم إبراهيم[148] أي الزموا دين أبيكم إبراهيم، فمن لم يكونوا أهلاً لتحطيم الأصنام أو كانوا ممن يتقاتلون بالفؤوس فإنَّهم ليسوا من ذرّية إبراهيم الخليل×، إذن فمن الممكن أن تكون للإنسان شجرة طويلة من الآباء هم سلسلة الأنبياء ونحن بمنزلة أبنائهم، وهذه النسبة والشجرة تبدأ من الحسين بن علي× وأهل بيت العصمة والطهارة^ وتنتهي في قوس صعودها إلى الأنبياء السالفين، وقد ورد هذا المعنى بحقّ سيّد الشهداء× وورد وصفه في الزيارة بأنّه وارث الأنبياء: «السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله...»[149] ويمكن إطلاق هذه العبارة على كلّ شهيد ولكن مع الحفاظ على مرتبة كلّ واحد بحسبه، والإمام الحسين× قد حظى بإرث الطبقة الأولى، وأمّا الآخرون فقد نالوا إرث الطبقة الثالثة، فالميراث غير متساو من حيث المقدار للورثة، والوارثون غير متساوين من حيث المنزلة[150]، وهذا الطريق مفتوح في ظلّ العقل والعدل، ويمكننا أن نقطعه ونصبح من أبناء هذه العائلة، فإنّ لهذه المنزلة دور كبير في جعل عمليّة تبليغ الرسالة مؤثّرة.
الجرعة الثالثة: محورية الحقّ للكون
تناول الإمام الحسين بن علي÷ خلال خطبه قضيّة الحقّ والباطل، فهناك تكليف يتعلّق بالحقّ والباطل يلزم على جميع الناس إدراكه والعمل به، وذلك التكليف هو: ضرورة قناعة كلّ إنسان بحقّه، فلا يظلم ولا يتعدّى على حقوق الآخرين، ويكون رافضاً للظلم بما تحمل الكلمة من معنى، وهذا من أبجديات نهضة كربلاء.
الحقّ الذي ورد في خطب وكلمات الإمام الحسين× له معاني متعدّدة، ويقابله الباطل وله معان متعدّدة أيضاً، إنّ سيّد الشهداء× قبل أن يصل إلى كربلاء قال للحر وجيشه: «ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه»[151].
المعنى الأوّل للحقّ: هو الحقّ الذي لا مثيل له في العالم ولا ندّ له، وهو الله سبحانه وتعالى: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ)[152]، والكلام حول هذا الأمر خارج عن إطار بحثنا وله مجاله الخاصّ به.
المعنى الثاني للحقّ: هو الذي فيه صبغة قانونية لا أكثر، ويُذكر في الفقه والقانون، ويجب على أفراد المجتمع مراعاته، من قبيل حقوق الأب وحقوق الأُم وحقوق المعلّم وحقوق الجار و... .
المعنى الثالث للحقّ: هو الذي فيه طابع المخلوقية، والقرآن الكريم يتكفّل ببيانه «حقّ مخلوق به» أي: أنّ الله قد خلق جميع نظام الوجود بما فيها السماوات والأرض بالحقّ، وهذا المعنى لا يمكن إثباته ولا نفيه في العلوم التجريبيّة، بمعنى أنّه إن قال الباحث الحسّي والتجريبي: «إنّي أستطيع نفي مضمون هذه الآية، أو أستطيع نفيها أو أشكك فيها» فقد أخطأ؛ وذلك لأنّ العلم الحسّي والتجريبي لا يمكنه أن يُثبت العلوم التجريديّة المحضة ولا أن ينفيها، ولا حتّى أن يشكّك فيها؛ لأنّ الإثبات والنفي والشك فرع التصوّر الصحيح للمسألة، وهذه الأمور لا يمكن إدركها من خلال العلوم الحسّية والتجريبيّة.
إنّ العلوم التجريبيّة والحسّية يمكنها أن تحقّق وتبحث في مجالات وتجيب على تساؤلات من قبيل الكوكب الفلاني يحتوي على أيّ نوع من أنواع المعادن؟ وهل يوجد فيه ماء أو لا؟ وهل يمكن الحياة فيه أو لا؟ وهل فيه هواء أو لا؟ وما هي العناصر والمواد الأوّلية لذلك الكوكب؟
كما لا يوجد في علم الرياضيات كلام حول نظام العالم وهل هو قائم على الحقّ أو الباطل؛ لأنّ الرياضي لا يمكنه أن يثبت أو ينفي بعلم الرياضيات قيام نظام العالم على أساس الحقّ أو الباطل، أو حتّى أن يشكّك في ذلك.
والأعلى من العلوم الحسّية والتجريبيّة والرياضيات هو علم الحكمة والكلام، والأعلى منه علم العرفان النظري الذي يتناسب جدّاً مع مكانة هكذا أحاديث، ولكنّ علم الوحي الواسع الميتافيزيقي ـ والذي يتكفّل القرآن ببيانه ـ بواسطته يمكننا الحديث عن أحقّية وباطليّة المصالح الأساسية التي تبتني عليها السماء والأرض، ونتوصّل إلى نتيجة مفادها أنّ مصالح خلق هذا العالم وإيجاده حقّة، وهذا المطلب الخارج عن الطبيعة لا ينسجم مع العلم والثقافة المادّية.
فالدنيا محبّتها رأس جميع الأخطاء الفكريّة والعمليّة، وهي بنيان لم يتمّ تشييده بالطين والحجر، وإنّما موادّه الغفلة، ما يعني أنّ أعمدته وسقفه وأرضيّته وجدرانه وخارجه وداخله بُنيت من الغفلة، فالدنيا بما فيها الأرض والسماء والبحر والبر ليست مجمّعاً تجارياً، إن هي أمر اعتباري صنعته الغفلة، وفي النقطة المقابلة يرى القرآن أنّ هناك نظاماً إلهيّاً قد بُني على الحقّ، ولهذا فجميع المواد الإنشائية للخلقة والتي هي آيات إلهيّة مبنيّة على الحقّ، وجميع الموادّ الإنشائية لعالم الدنيا مبني على الغفلة. فكلّما غفل الإنسان فليعلم أنّه وقع في شباك الدنيا، وكلّما كان ذاكر لله فليعلم أنّه في أجواء الآخرة.
وحي الأنبياء والأولياء^ ميزان وسلطان يُلقي بضلاله على جميع العلوم والمعارف العاديّة، فجميع تلك العلوم يجب أن تُعرض على الوحي الإلهي، ومن خلال تلك المعارف الإلهيّة نتمكّن من إثبات أحقّية خلق السماء والأرض بسهولة، وهذا يعني أنَّ من أراد أن يبدأ برحلة صحيحة موصلة للهدف والكمال المنشود فيلزم أن تكون بداية رحتله وانطلاقة مسيرته حقّة، والمسافر الذي لم تتوفّر له هذه الشروط سينقطع به الطريق ويصبح ابن سبيل ولا يصل إلى مقصوده.
إنّ الحقّ والباطل في كلمات سيّد الشهداء× لا ينحصران بالظلم والعدل، بالرغم من أنّ الظلم ومحاربته وإقامة العدل وجهان بارزان في النهضة الحسينية، ففي كلّ ميدان يأتي حديث الحقّ والباطل وهما يشتملان على مصاديق كثيرة من جملتها الظلم والعدل، وعليه فذكر الله وشكره والتفكر فيه حقّ، والغفلة باطل، والحسين× قد حارب الغفلة وعبادة الدنيا، وبما أنّ السعي وراء الباطل والأنانية من الغفلة، لذا صدح سيّد الشهداء× بقوله: «الباطل لا يُتناهى عنه»[153]يعنى لماذا لا تجتنبون الغفلة عن الحقّ؛ إلّا أنّ سبب غفلتهم هي أنَّ الحكومة الأموية أدخلت الأمّة في سُبات عميق من الصعب جدّاً على الإمام الحسين× أن يوقظها إلّا ببذل الدماء والمهج.
وهكذا بذل سيّد الشهداء× دمه ومهجته لتحقيق أمرين، الأوّل: القضاء على الجهل، الثاني: إزالة الغفلة، ليستنقذ الأمّة من الجهل العلمي، والضلال العملي، ويهديهم إلى العلم والعقل، كما جاء في زيارة الأربعين: «وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحَيرة الضلالة»[154].
فما لم يصبح المجتمع عالماً لا يتّجه نحو السعادة، وإن أصبح عالماً وقطع شوطاً من الطريق لا يبلغ هدفه ـ أبداً ـ ما لم يكن عاقلاً، وبما أنّ الإمام× كان حكيماً هادياً مهديّاً كان يسعى ببذل مهجته لتربية الأمّة تربيةً تجعلها أُمّة عاقلة مهتدية، وحينئذ يضع على عاتقهم وظيفة السفارة والهداية.
فالأمّة ـ نظراً لما تقدّم ـ التي تحمل على عاتقها مسؤوليّة تبليغ رسالة الإمام الحسين بن علي÷ يجب عليها:
أوّلاً: أن تستنقذ نفسها من الجهالة وتصبح أُمّة عالمة. وثانياً: أن تبتعد عن الضلالة وتصبح حكيمة، ثمّ تتّجه لهداية الآخرين. وبوصول الإنسان إلى هذه الدرجة سيَفهم ويُفهم الآخرين أنَّ الموت ليس فناء، بل هو نزع الروح من البدن، لا كما يتصوّر الكثير أنّ الإنسان كالفاكهة الناضجة تفسد بالموت.
وتمتاز الأمّة التي تحمل رسالة الإمام الحسين بن علي÷بأنّها ترى روح الإنسان كطائر يحلّق عالياً عند الموت ليعود إلى عشّه الأصلي حيث ينعم بالاطمئنان والهدوء إلى جانب حبيبه.
|
مرغ
باغ ملكوتم نِيَم از عالم خاك چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم[155]. |
وعلى حدّ تعبير حافظ:
|
این
جان عاریت که به حافظ سپرده دوست روزی
رخش ببینم وتسلیم وی کنم[156]. |
لقد جاء في القرآن الكريم أنّ جماعة من الناس سيُحشرون يوم القيامة سود الوجوه (وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ)[157] وحينما يسألهم الملائكة بماذا جئتم من الأعمال لهذا اليوم بعد ما أمضيتم السنين الطويلة في الحياة الدنيا؟ فيقولون ـ حينما لا يجدون إجابة واضحة ـ كنّا سجناء، والسجين لا يُتوقّع منه الهدايا. أمّا إذا وُجّه السؤال للأولياء والشهداء والعلماء والصلحاء سيُقدّمون أعمالهم الصالحة التي تفرح بها الملائكة؛ لأنّ هذه الطائفة قد عملت بهذه الوصيّة (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)[158] وعليه فمن ينتفع من التعاليم القرآنية ويرتوي من معين المعارف الحسينية فإنّه لا يعدّ غافلاً عن سفر الآخرة، وقد أعدّ لها زاداً ومتاعاً.
نعم، فإنّ السفارة العامّة للمجتمع الإسلامي هي قيام كلّ إنسان بتكاليفه ونشاطه في أيّ مجال، فهذا المقطع من كلمات الإمام الحسين× يُفهمنا أنّ عناصر هذا العالم قائمة على الحقّ، فبقاع الأرض كالمسجد والحسينية تسمع وتبصر:
وبتعبير بديع آخر:
|
موسى
ای نیست که دعوی انا الحق شنود ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست[161]. |
وهذا يعني نداء (أنا الحقّ) في مقام الفعل يصل من خلف حجاب جميع الأشجار، إلّا أنّه يحتاج إلى أُذن موسويّة كي تتمكّن من سماع الصوت من وراء تلك الحجب والأشجار، وتدرك هذه الحقيقة أنّ مكوّنات السماوات والأرض حقّ، وليس هناك منفذ للباطل في الخليقة أبداً.
فإذا وصل إنسان إلى هذا المستوى أصبح حينئذ عضواً في المجتمع الإسلامي وسفيراً للإمام الحسين×، وعلى عاتقه إيصال رسالة إلى العالم، تقول: إنّ الغفلة تشكّل سقف هذه الدنيا وسطحها، فكلّما غفلنا عن الله فذلك الباطل والدنيا، وكلّما ذكرنا الله فهو الحقّ والآخرة.
إنّ الحسين بن علي÷ نهض لأجل أن يُعرّفنا على الحقّ، وإلّا فإنّ محاربة الظلم على اختلاف مراتبها كانت ولا زالت، وما أكثر المجاهدين الذين دُفنوا في كتب التاريخ. الإمام× كان متناغماً مع النظام الكوني بأكلمه، ولذا لما قال: «ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به وإلى الباطل لا يُتناهى عنه»[162] لم يكن يوجّه الخطاب إلى الأمويين والعباسيين والمروانيين فحسب، بل إلى جميع الماركسيين والشيوعيين والإرهابيين والملحدين والمادّيين المستكبرين إلى يوم القيامة.
فخطاب سيّد الشهداء× معناه اعلموا أنّ نظام الوجود قائم على الحقّ، وبغرقكم بالباطل سينهار نظامكم هذا، وهذه المهمّة قد توكل أحياناً للأرض ومثالها ما حدث لقارون: (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ)[163]، وأحياناً للبحر كما في غرق آل فرعون: (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ)[164]، أو التاريخ كما حصل للسلالة البهلويّة والقاجارية ونظام الاتحاد السوفييتي[165]؛ لأنّ نظام الخليقة وكلّ ما فيه حقّ، السماء والأرض والزمن جنود لله الرحمن الرحيم والقهّار والمنتقم عند الضرورة: (وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ)[166](وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ)[167].
فبما أنّ نظام الوجود قد خُلق بالحقّ، لذا فإنّ الظلم، وترك الصلاة، وأكل الربا، وغصب الأموال، والمؤامرات على الحكومة والشعب وأيّ ذنب يُقترف هو باطل (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ)[168].
إدراك حقّانيّة العالم منوط بالتقوى
يرى منطق الوحي أنّ كسب المعرفة بحاجة إلى مرحلة أعلى من مرحلة الحسّ والإحساس، وليس ذلك إلّا التقوى، وكما قيل: إنّ من يمتلك حسّاً يمتلك العلم الناشئ عنه، ومتى ما فقده فقد العلم الناتج عنه، فإنّ التقوى هي كذلك أيضاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا)[169] فما دام الإنسان يمتلك التقوى فهو يمتلك العلم الناتج عنها، ومن باب المثال: إذا كانت لديه تقوى بالشأن المالي فإنّه سيمتلك العلم الحاصل عنها، وبفقدان أيّ نوع من أنواع التقوى سيفقد العلم الناجم عنها.
فأهل التقوى يُدركون أنّ المنظومة الكونيّة قد خُلقت بالحقّ، وكلّ ما فيها شهود على أعمالهم، وهذا يعني أنّه إذا امتدّت يده يوماً ما إلى معصية فإنّ كلّ ما أحاط به سيشهد عليه في يوم المعاد؛ فلا يرتكبون المعاصي خوفاً من الفضيحة.
إنّ آية (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ)[170]وبالرغم من أنّها جاءت تختلف عن الآية 29 من سورة الأنفال[171] حيث لم تكن على شكل شرط وجزاء، إلّا أنّ الاقتران الوارد فيها بين العلم والتقوى يدلّ على أنّ الشخص إن أصبح متّقياً سيعلّمه الله أمراً لا يعلمه الآخرون. ونظراً لهذا يرى القرآن الكريم: أنَّ المتقين لديهم أعين وآذان يسمعون بها حديث قلوبهم وحديث الأنبياء؛ وأنّ الله قد جعل في أفئدتهم أجهزة استقبال باطنية بها يسمعون الخطاب الإلهي دوماً، ومن هنا قيل: انصتوا ليلاً ونهاراً وتأمّلوا بدقّة لتسمعوا نداء بواطنكم.
وكما أنّ فعل (كان) في قوله تعالى: (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا)[172] وقوله كذلك: (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)[173] لا يختصّ بالزمن الماضي؛ لأنّ الله تعالى منزّه عن المكان والزمان، كذلك قوله تعالى: (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)[174] أيضاً مجرّدة عن الزمان، فقوله (فألهمها) لا تعني أنّ الله قد ألهم الإنسان الفجور والتقوى لفترة من الزمن وانتهى الأمر، وإنّما المعنى: أنّ تلك الذات المتعالية تُطلع الإنسان في كلّ آن آن على الهاوية والصراط المستقيم، إلّا أنّ العيون الباصرة والآذان الصاغية قليلة.
إنّ آيات الله مستمرَّة، فبعض الناس آذان باطنهم واعية، وبعضهم صمّوا أسماعهم، فهم في عزلة عن سماع صوت الحقّ، وهناك طائفة هم أهل الشهود، وفريق قد أعموا أبصارهم (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ)[175].
وهناك من بلغوا درجة من الصمَم والعمى بحيث يُحرمون من رؤية ربّهم حتّى في يوم تجلّيه التام يوم القيامة، اليوم الذي يعترف فيه المجرمون بخطاياهم على أمل أن ينالوا العفو من الله: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)[176]؛ و(كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ)[177]، وكذلك حالهم حينما يشتدّ عليهم العذاب، ويخاطبون ملائكة العذاب الموكّلين بالجحيم: (لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ)[178]، فينادونهم بكلمة ربّك حتّى في مثل هذه الظروف، وما زالوا في غفلة عن كلمة (ربّنا).
إنّ سيّد الشهداء× قبل أن يصل إلى كربلاء قال للحرّ وجنوده: إن أردتم أن تُصبحوا حسينيين وتثوروا إحياءً للحقّ ومن أجل القضاء على الباطل، يلزمكم الشوق إلى لقاء الحقّ: «ليرغب المؤمن في لقاء الله محقّاً»[179] أي: لا يحلّ لكم أن تغضّوا أبصاركم وتكفّوا أسماعكم عن دعوة الحقّ، وعليكم بتناول الزاكي من الطعام والتحدّث بالطيّب من الكلام.
إنّ رسول الله’ يأمرنا بتطهير أفواهنا؛ وذلك لأنّنا نقرأ سورة الحمد وسورة التوحيد، ونتحدّث بهذه الأفواه مع الله تعالى: «طهّروا أفواهكم فإنّها طرق القرآن»[180] إنّ تنظيف الأسنان تكليف ديني مستحب، ويترتّب عليه الأجر والثواب، إلّا أنّ النبي الأكرم’ لم يقل: (نظّفوا أسنانكم)، بل قال: «طهّروا أفواهكم» كي لا يدخلها الأكل الحرام، أو يخرج منها كلام سيّء؛ لأنّ الفم هو الممرُّ والطريق الذي تسلكه ألفاظ القرآن الكريم.
وسيّد الشهداء× الطاهر الطيّب والمصداق البارز لقوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)[181] وقد تلى بفمه الطاهر والطيب آية (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)[182] موصياً بها الجميع.
الجرعة الرابعة: الأساس الفكري للنهضة الحسينيّة
إنَّ النهضة الحسينيّة قائمة على الحقّ، كما فی غیرها من النهضات الإلهيّة التي قام بها أولياء الله، ويتصوّر الآخرون أنّ الضعيف مدحور في قانون الطبيعة، فميزان القوّة والضعف عندهم يتمحور حول الطبيعة والمادة، فكلّ موجود يتمتّع بطاقات ماديّة فهو قويّ ـ بزعمهم ـ والضعيف من كان فاقداً لها، وعلى هذا الأساس أُقيمت الأنظمة وأُنشأت الحكومات؛ وعلى خلافهم مضمون ما جاء به الأنبياء من أنّ الحقّ في هذا العالم ثابت وأبديّ والباطل مدحور وزاهق، ونهضوا على هذا الأساس وانتصروا، وخرج أئمّة الجور اعتماداً على رؤاهم فهُزموا.
إنّ سلسلة الأنبياء عند الله} متّصلة ومستمرّة، وسلسلة أئمّة الجور منقطعة وزائلة؛ لأنّ الأنبياء يدعون الناس إلى الله تعالى: (إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ)[183]، أمّا غيرهم فلديهم دعوات متنوّعة، وضمناً يدعون لأنفسهم، فجاء الأنبياء ومضوا لكن فكرهم ظلّ ثابتاً وخالداً في الدنيا، وأمّا أئمّة الكفر فقد جاؤوا ثمّ مضوا ولم يُخلّفوا شيئاً في هذه الدنيا سوى أسماءهم التي دفنها التاريخ: (وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ)[184] وباستطاعة المؤرّخ أن ينبش قبر التاريخ ليستخرج أسامي أئمّة الظلم وقادة الطغيان والحكّام المستبدّين كالحشائش الضارّة التي تنبت بين الزروع، فيقتلعها البستاني ويرميها بعيداً.
فحديقة العالم فيها أشجار مثمرة دائماً، وإلى جانبها تنمو أعشاب ضارّة، وذلك أنّ الحديقة لم تُنشأ من الأساس للأعشاب الضارّة، وإنّما تظهر كلّ يوم ثمّ تتمّ إزالتها، بيد أنّ الأشجار المثمرة تبقى مترابطة ومتّصلة دائماً: (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا)[185]، فعالم الوجود دائماً ما يثمر ثماراً ناضجة وطيّبة، والأعشاب الضارّة متى ما نمت أُزيلت وأُلقي بها بعيداً: (كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ)[186] فمدبّر الوجود بحكمته يغذّي هذا العالم لتنمو شجرة طوبى التي: (أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)[187]، وكلّما أراد غريباً أن يشعل ناراً أو حرباً ضدّ الدين أطفأها الله، ويستفاد من التعبير بفعل الماضي (أطفأها) إسناد الإطفاء إليه ولم يسنده إلى الفلك والعالم، وهذا يعني أنّ إرادة الله لا رادّ لها، وهي متصدّية لدحر حكومة الجور، ومن هنا فإذا أراد الجائرون إطفاء النور الإلهي لا يقدرون على ذلك أبداً: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ)[188] و(وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ)[189].
وبناء على هذا فإنّ نور الله تعالى ثابت ودائم، وهو سبحانه دائماً ما يُخمد نار الطواغيت، إذ تلك النيران غير مترابطة فيما بينها: (وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ)[190] حالها حال الأعشاب الضارّة التي تُزال ويُقضى عليها بحشّها لمرة واحدة، وعلى العكس من الأنبياء فهم سلسلة متواترة مترابطة الحلقات: (ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى)[191] وهكذا رسالاتهم وكتبهم: (وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ)[192].
کما يستفاد من کتب سيّد الشهداء× وخطبه أنّ نهضته لها مبدأ وأساس، كما كان خروج الأُمويين أيضاً كذلك. فالإمام× بما أنّه كان يؤمن بأنّ نظام الوجود قائم على انتصار الحقّ واندحار الباطل، فنهضته ستكون قائمة على هذا الأساس، أمّا الأُمويون فمبدؤهم أنّ من يمتلك القدرة المادّية هو المنتصر، ومن لا يمتلكها فمحكوم عليه بالفشل والخسران، وفي الواقع يعود الاختلاف بين هذين النموذجين من التفكير إلى الاختلاف في الرؤية الكونية التي يحملها كلّ منهما، وقد كانا في الماضي وسيستمرّان في المستقبل، بيد أنّ بقاء الأفكار الباطلة ودوامها كاستمرار الأعشاب الضارّة المفكّكة دائماً.
أسباب الإعراض عن مبادئ النهضة الحسينيّة
كما ورد في القرآن الكريم أنّ الدفاع عن تراب الوطن ومائه لا يمكن أن يجتمع مع العافية والرفاهية، ولما أُخرج بنو إسرائيل من ديارهم، قالوا لنبيّ زمانهم أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيّن لنا قائداً عسكرياً كي نقاتل تحت لوائه ونأتمر بأمره، قال لهم نبيّهم: قد لا تصمدون، فقالوا كيف لا نصمد ونتحمّل، وقد أخرجونا من ديارنا وفرّقوا بيننا وبين أبنائنا؟! لذا فسنصمد ونقاوم لا محالة: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا)[193] وعندها بعث الله تعالى قائداً اسمه طالوت واختاره لهم وابتلاهم بأمر، ففرقة منهم نجحوا في الاختبار وفشلت الفرقة الأخرى، ثمّ اختبرهم بأمر آخر فنجحت طائفة في الابتلاء الثاني وفشلت طائفة أخرى، والفرقة التي نجحت في كلا الاختبارين هي التي استطاعت دحر العدو وتحرير الوطن واسترجاع الأموال المنهوبة[194].
الاختبار الأوّل: كان اختباراً أخلاقياً معنوياً، وذلك لما عيّن الله تعالى طالوت قائداً عسكرياً عليهم افترق المتأهّبون للحرب فرقتين: فمَن يطلبون الجاه قالوا لا يحقّ له أن يصبح قائداً عسكرياً علينا ونحن أليق بذلك منه: (وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ)[195] وقال آخرون نطيع أمر الله تعالى ورسوله ونتّبع مَن اختاره الله} قائداً عسكرياً علينا. نعم، متى ما صدر من أحد ادعاء المنصب والوجاهة وسمع الناس ذلك منه فإنّه شيطان والقائل: (وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ) قد اتبع الشيطان الذي قال: (أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ)[196].
الاختبار الثاني: كان ماديّاً، حيث أخبرهم قائدهم العسكري طالوت عن الله تعالى بالعزم على الذهاب إلى ميدان الحرب، ومواجهة المشاقّ والمتاعب والعطش، وعندما ينال منّا العطش والتعب ويأخذ منّا مأخذاً وتكون الوجوه قد اغبرّت والأكباد قد تلظّت من الظمأ سنجد نهراً، فالمجاهد هو من لم ينهل منه ويظلّ يقاسي ألم العطش، ومن شرب منه أصبح من طلّاب العافية والراحة: (فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ)[197].
انقسموا في هذا الاختبار إلى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى قد أروت عطشها من النهر بشكل كامل، فلم تقوى على الذهاب إلى ميدان الحرب بعزيمة، والطائفة الثانية: ذاقوا منه قليلاً، والطائفة الثالثة: عدّوا من خُلّص أصحابه لا لأنّهم لم يشربوا وحسب، بل لم يتذوّقوا طعمه، وفي آخر المطاف وجد طلّاب العافية والراحة أنفسهم غير قادرين على المتابعة فاعتزلوا ميدان القتال، وأمّا الطائفتان الأُخريان اللتان تعتقدان بأنّ الباطل زاهق في هذا العالم، وشعروا بالقدرة على مواصلة القتال وهم على قناعة تامّة بالنصر رغم قلّتهم: (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ)[198].
إنّ سيّد الشهداء× كان يعظ الناس في ميدان الحرب بمواعظ تزجرهم عن طلب الجاه كي لا يمنعهم ذلك من الدفاع عن الحقّ كما قال×: «الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرّفة بأهلها حالاً بعد حال»[199] ويستفاد من هذا الكلام أنّ الأمور الجميلة بنظر العرفاء والأولياء مقلقة ومخيفة بالنسبة لغيرهم، وما يزعم الآخرون جماله من زخارف الدنيا وبهرجتها يفرّ منه الأولياء وهم منه على حذر، وبناء على هذا فمن يرى أنّ العالم جميل بأسره سيجد جمال الدنيا بتغيّر أحوالها، معتقداً أنّ تغيّر أحوالها نعمة، لا بدّ من أداء حقّها، ولذا قال الحسين×: «فالمغرور من غرّته، والشقي من فتنته»[200] وبما أنّ زخارف الدنيا قد امتزجت بالجمال صارت من حبائل الشيطان، إلّا أنّ مكر الله} جميل وليس مكره قبيحاً.
انتشر الباطل في عصر الإمام الحسين× بسبب عدم وجود نور الحقّ، والسرّ في انتشار الباطل هو لقمة الحرام، وارتكاب المعاصي، ولهذا قال الإمام الحسين×: «مُلئت بطونكم من الحرام»[201] وهذا يعني أنّ السبب في عدم قبولكم كلامي وسماعكم نصحي أكلكم الحرام، وكانت الإجابة ـ بدلاً من الانتباه من الغفلة ـ قولهم: «ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين»[202] أي: إنّا لا نشكّ في خروجك عن الدين ووجوب قتالك، عندها أخبرهم الإمام الحسين× بأنّ الحقيقة ستتبيّن فيما بعد، ويتضح مَن الذي خرج عن الدين نحن أم أنتم، ولذا قال: «والله لتعلمنّ أيّنا المارق عن الدين»[203].
فجميع الأمّة الإسلاميّة مسؤولة وسفيرة وتتحمّل أعباء رسالة كربلاء، ويجب أن تدرك حدث كربلاء العالمي بصورة جيّدة، وتعمل بتلك الرسالة وتوصلها إلى الآخرين.
وقالها أمير المؤمنين× مخاطباً من يستأكل بالباطل تحت غطاء الحقّ وباسم الحقّ، يحمّل باطله الآخرين، بأنّنا لا نتصالح ولا نتوافق مع هكذا شخص، فإن قبلت الحقّ فهذا هو المطلوب، وإلّا فأنت غريب عنّا (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)[204].
ونفس هذا الكلام قاله سيّد الشهداء× لأتباع بني أُميّة آكلي الحرام: «أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون»[205] نعم، فالحقّ والباطل لا يمكن أن يجتمعا في مكان واحد، وأکل الحرام يجعل ابن آدم في مصاف أهل الباطل.
الجرعة الخامسة: معطيات النهضة الحسينيّة
إنّ لنهضة كربلاء رسائل تعليميّة تهمّ الجميع وتشمل كلّ مجالات الحياة وشؤونها، ينبغي التعرّف عليها جيّداً والاستفادة منها، ولا بدّ من إحيائها، وإحياؤها لا ينحصر بالرثاء والبكاء على سيّد الشهداء، بل العلماء انتفعوا من نهضة كربلاء في جميع المجالات؛ من الحكمة، والكلام، والفلسفة، والعرفان، كما انتفع القادة السياسيون والاجتماعيون ببركاتها بنحو آخر.
وما زالت رسالة كربلاء حتّى اليوم تُلهم المسلمين طاقة واستعداداً للصمود بوجه جميع التحدّيات دون أن ينفذ إليها الخوف: «إنّي لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برماً»[206] وهذا ما يوجب على الجميع التعرّف إلى مذهب أهل البيت( والمحافظة عليه، والعمل على إعداد الأمّة وتعزيز قواها وتعبئتها للحضور العام في سوح المواجهة مع العدو.
الرسالة الأخيرة للنهضة الحسينيّة هي ذات الهدف النهائي للدين، وهو وصول الإنسان إلى كماله المنشود ببلوغ الحدّ الملائكي لا الإنساني المعتدل، فلو طلب الإنسان العلم وهذّب نفسه وأصبح عالماً أميناً متواضعاً حليماً عادلاً فهو إنسان جيّد، ولكنّه ما زال إلى الآن في وسط الطريق ولم يصل إلى الهدف بعد؛ لأنّ باطن الذنب مستنقع قذر، فكما لا يعدّ العبور من جوار كنيف دون التلوّث بالنجاسة فنّاً، هكذا ترك الذنوب واعتدال الإنسان لا يعدّ فنّاً أيضاً، وعلى الإنسان بلوغ الكمال الإنساني وأن يصبح نورانيّاً. (الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)[207].
وسيّد الشهداء× جعل أصحابه وأنصاره نورانيين ملائكيين إلى درجة أن أراهم ليلة عاشوراء منازلهم في الجنّة؛ لأنّ المتقين ـ كما وصفهم أمير المؤمنين× لهمّام ـ يبلغون بتقواهم درجة كمن يرى الجنّة، ويُعبّر عن هذه المنزلة بمقام (كأنّ) أو الإحسان حيث يقول: «فهم والجنّة كمن رآها فهم فيها منعّمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذّبون»[208]، والدرجة الأعلى منها مقام (إنَّ) التحقيقية وفيه يرى الإنسان الجنّة حقيقة، وهذا ما حصل في ليلة عاشوراء حيث إنَّ الإمام الحسين× أرى أصحابه وأنصاره الجنّة[209]، وكلّ إنسان بلغ هذه المنزلة فقد وصل إلى الهدف المقصود، ومن لم يبلغ هذه المنزلة فلم يصل بعد إلى الهدف، وإن نال درجة متوسّطة من السعادة.
طبعاً سيشعر الكثير من الناس يوم القيامة بالحسرة، فالمجرمون بسبب سيّئاتهم، والمتقون لقلّة تقواهم، إلّا أنّ الأفق التفكيري الضيّق للبعض يوهمه أنّه قد بلغ أعلى الدرجات بمطالعته لمجموعة من الكتب، أو قيامه بعمل من أعمال الخير، وحكاية هؤلاء كالأطفال حينما يمارسون بعض ألعابهم الطفولية مستخدمين السيقان الخشبية حتّى يكونوا أطول من الآخرين.
اگر کوتهی پای چوبین مبند
که در چشم طفلان نمایی بلند[210].
إذن فمن يدّعي لنفسه العلم وغيره من الصفات الحميدة لا يمكنه أن يصل ـ بزعمه هذا ـ إلى مبتغاه وهدفه، وهذا كمن يخدع نفسه في لعبة الأطفال على أنّه أطول منهم، وما أضيق الأفق الفكري لمن يزعم هذا. نعم، إنّ الرفعة وعلوّ الدرجة يمكن معرفتها في ضوء العلاقة مع الله (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ)[211](فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ)[212](وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا)[213] مثلما جعل سيّد الشهداء× أصحابه يبلغون تلك الدرجات الرفيعة.
إنّ هدف الدين لا يقتصر على منع البشريّة من أخذ الرشوة، وإنّما يسعى أن يبلغ بالبشريّة درجة يمكنها رؤية باطن الرشوة والربا، ويجعلها تستثمر أموالها بالطريقة الصحيحة لرفع مستوى الإنتاج والعمل؛ وما يحصل عليه من فائدة طاهراً طيّباً؛ وذلك لأنّ الربا والرشوة وما شابههما قذارة: (وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ)[214] والمرتشي كبئر للقاذورات، والراشي كمن يُلقي دلوه فيه ليخرج مقداراً من تلك القذارة[215].
لقد كانت مسألة الموت محلولة عند أصحاب وأنصار سيّد الشهداء×، ويشهد له لسان حالهم ومقالهم، حيث كانوا يبتسمون للموت ويستأنسون به، غير مكتفين بالقتلة الواحدة متمنّين القتل ونيل الشهادة بين يديه مرّات ومرّات، والامام الحسين(عليه السلام) صرَّح هو بأن لقاء الله ليس هدفي وحدي فحسب، بل ينبغي أن يكون ذلك هو الهدف الأساسي لأصحابي أيضاً [216].
وطبقاً لما جاء في خطبة السيّدة زينب الكبرى‘ في الشام فإنَّ رسالة كربلاء باقية وخالدة حيث أقسمت قائلة: «فو الله، لا تمحوا ذكرنا ولا تميت وحينا»[217]، وهذا يعني أنّ ذكرنا ليس من الحجر والتراب حتّى تطأه الأقدام ويبقى مخفيّاً، إنّه نور لايطفأ أبداً، ويُشرق في شتّى الأحوال والظروف، ولن يستطيع الاٌمويّون ولا أيّ قدرة غاشمة أخرى إزالته.
زعمت السلطة الأُمويّة الجهنّمية أنّها بقتلها الحسين× ستتمكّن من دثر أعلام النبوّة والوحي، وجعلها في طيّات النسيان، وهذا ما دفع السيّدة زينب الكبرى‘ أن تُقسم في خطبتها الحماسيّة في الشام وإلى جانب رأس أخيها أبي عبد الله× وبحضور الإمامين زين العابدين والباقر÷ بالله} أنّ الحسين× سيبقى حياً إلى الأبد.
جدير بالذكر: أنَّ الإمام الحسين× لم ينل الشهادة ليكون شفيعاً لنا لندخل الجنّة؛ وذلك لأنّ هذه الفكرة فكرة مسيحية باطلة، وهي غير جامعة ولا مانعة طرداً وعكساً، حيث إنّ بقيّة الأئمّة^ الذين لم يشهدوا واقعة كربلاء لديهم مقام الشفاعة كما للإمام الحسين×، والذين كانوا حاضرين في كربلاء لا يصلون إلى درجة الإمام×، بناء على هذا فحقّ الشفاعة شيء ورسالة كربلاء شيء آخر، وعلى حدّ تعبير الإمام الرضا× يجب إحياء أمر الأئمّة^ دائماً: «رحم الله عبداً أحيى أمرنا»[218].
الجرعة السادسة: القيم وأضدادها
إنّ نهضة عاشوراء تعلّم الإنسان كيف يميّز بين الحقّ والباطل، والصدق والكذب، والحسن والقبح، والذلّة والعزّة، والعمى والبصر، والصمَم والسمع، والسفاهة والرشد، والموت والحياة، ويتعرّف إليها حتّى يتحرّك في مضمار تطبيق مصاديقها، ولا يقع في الخطأ عند أدائها.
وغالباً ما يظنّ الأشخاص العاديّون أنّ تشخيص معاني تلك الألفاظ أمر يسير، ظنّاً منهم بإمكانية معرفة معاني الألفاظ ومصاديقها دون الحاجة إلى مرشد ودليل، ولذا فالمتسلّط، والمنقاد، والمقارع للظلم، والمبلّغ، وبالرغم من وقوفهم على طرفي نقيض يرى كلّ طرف منهم أنّ الحقّ معه، مدّعياً انّه صادق، وعزيز، وكريم وحي، وبصير وحكيم، ولكنّ التمييز الصحيح إنّما يحدث عندما يُدرك الإنسان معنى الموت والحياة جيّداً، فإذا كان الإنسان حيّاً فهو بصير، وسميع، وحكيم، ومحبّ، وعزيز، وصادق، وكريم، وإذا كان ميّتاً فهو أعمى، وأصم، وسفيه، وباطل، ولئيم، وذليل.
وهذا التصنيف كان دائماً على مدى التاريخ، ومن نماذجه المواجهة بين موسى× وفرعون، فإنّ النبي موسى وأخاه اعتمدا أسلوب البيان والعمل، وأمّا فرعون فقد اتخذ نمطاً آخر، فكان يقول لأهل مصر: إنّي أدعوكم إلى العزّة والدين والاستقلال ووحدة الأرض والتراب؛ لأنّ موسى يريد أن يقضي على دينكم، ويلحق الضرر باستقلالكم ووحدة أرضكم، ويفسد مجتمعكم، ويثير الشغب، ويزعزع الأمن (إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)[219] وكان لكلّ من الطرفين أتباع وأشياع في ذلك المجتمع، ففرقة تؤمن بصحّة ما جاء به موسى كليم الله، وفرقة أخرى أيضاً تثمّن وعّاظ البلاط الفرعوني.
فقد حاول سيّد الشهداء× قدر الإمكان شرح المفاهيم والمعاني وتوضيحها للناس من خلال التعليم والتزكية والدروس والعبر والمواعظ، متأسّياً في ذلك بأبيه وجدّه وسائر أهل بيت العصمة والطهارة، ولما رأى أنّه لا فائدة من الكلام والموعظة، وأنّ الحلّ الوحيد لإيقاظ الأمّة هو بذل الدماء، عزم على نهضة عاشوراء؛ ليهدي للناس مفتاح جوهرة الشهادة كي يفتحوا به أبواب خزائن الثقافة الدينية، ليعلّمهم معنى العزّة والكرامة والاستقلال والأمن والحقّ والصدق من جهة، ومن جهة أخرى القدرة على تمييز الذلّة واللؤم والباطل والكذب، وأن لا يقعوا في الخطأ عند العمل.
نعم، قال سيّد الشهداء×: إن كنتم تريدون الحياة فقاتلوا «ما الموت إلّا قنطرة»[220] لكنّ هناك مَن يتصوّر أنّ الذهاب إلى الحرب يعني الموت، وهذان المنطقان بينهما فرق شاسع، ومن هنا يُستخلص بحث مفصلي اعتماداً على المعارف القرآنية بعد تلخيصها وإرجاع المتشابهات إلى محكماتها؛ لأنّه إذا عرفنا هذين المنطقين سنميّز الرذائل عن الفضائل، ولا يحل أحدهما محل الآخر، فلا يعدّ السفيه حكيماً: (لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا)[221](وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ)[222](وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)[223].
الجرعة السابعة: الدفاع والشمول في النهضة الحسينيّة
إنّ النهضة الحسينيّة ذات صبغة دفاعيّة، فكانت ثورة دفاعيّة لا هجوميّة ولا ابتدائيّة، وقانون الدفاع يختلف عن قانون الهجوم الابتدائي.
فالهجوم الابتدائي له أحكامه الخاصّة، كوجوب أن يكون المقاتل رجلاً بالغاً، فلا يجب على المرأة وغير البالغ، وأمّا في الحرب الدفاعيّة فلا فرق بين المرأة والرجل، كما ويُلغى شرط السنّ فلا فرق بين الشيخ والكهل والشاب، وحتّى غير البالغ يجب عليه الدفاع إن كان مميّزاً وعاقلاً.
وعليه فبما أنّ نهضة كربلاء تتسم بصبغة دفاعيّة فرسالتها دفاعيّة غير هجومية أيضاً، فالكلّ مساهمون في هذه النهضة؛ النساء والرجال، والكهول والشباب والشيوخ.
والقتال سواء كان دفاعياً أم ابتدائياً، يجب معرفة محوره الأساسي، إذ قد يتقاتل الرؤساء والقوى العظمى أحياناً من أجل الأرض وثرواتها الباطنيّة أو الأموال التي على ظهرها، ويسمّى مثل هذا القتال بحسب بعض اللحاظات بالجهاد الأصغر، أمّا في مجال الجهاد الأوسط والأكبر فلا نجد أثراً للأرض والمتاع واللباس في محورهما الرئيس، وإنّما ستبرز هناك دواعي مثل الرئاسة والجاه والهيمنة والسيطرة ونحوها.
فالحرب قائمة في الجهاد الأوسط بين العقل والهوى، وهذا الصراع لا يتمحور حول الطعام واللباس؛ وذلك لأنّه لا غريزة طلب الجاه من شأنها أكل الطعام، ولا العقل. فالقوّة العاقلة منزّهة عن الأكل واللبس. فالحرص والطمع وطلب الجاه في دائرة التجرّد الوهمي، أما العقل فدائرته التجرّد العقلي.
فالموجود الذي تجاوز وبرز عن طبيعته الغريزية، سواء كان ظهوره على شكل الهوى وطلب الجاه أو على شكل الهداية العقلية غذاؤه الرئاسة.
فالهوى يطلب الرئاسة في ساحة الباطن، والعقل يطلبها في دائرة النفس، والصراع بين العقل والهوى في الإطار الأخلاقي من أجل المنصب، فالعقل يقول للهوى: الويل لك هذا المنصب منصبي، إذ لا يحقّ لك التحكّم بالإنسان، ولكنّ الهوى والطمع يحجبان العقل ويدَّعيان لأنفسهما منصب الجاه والرئاسة.
الأحداث في فترة ما بين الغدير والسقيفة خير نموذج كاشف ودالّ على هذا الصراع، وإن كانت الأطماع الماديّة ملحوظة أيضاً.
فالشخص الذي حظي في واقعة الغدير بمنصب «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»[224] كان له الحقّ بادعاء الرئاسة المشروعة، وفي مقابله القائل: «منّا أمير ومنكم أمير»[225]حيث يدّعي بذلك الرئاسة غير المشروعة.
وإذا تجاوزنا مرحلة الجهاد الأوسط سندخل إلى دائرة الجهاد الأكبر، فيبدأ صراع جديد بين العقل والقلب، فالعقل يسعى إلى الفهم والإدراك ولا يستطيع أن يصل إلى مرتبة أعلى من الفهم، والقلب ينطلق من الفهم ويعدّه الدرجة الأولى، محاولاً رؤية ما فهمه، فأنت أيّها العقل تريد أن تقيم دليلاً على الجنّة والنار والقيامة وتطاير الكتب، وأمّا أنا القلب فقد تجاوزت جميع هذه المراحل وأُومن بها، إلّا أنّي أُريد ـ حالياً ـ أن أرى جهنّم وأهلها والجنّة وأهلها.
القلب يحاول الوصول إلى الرؤية والشهود، والعقل يسعى إلى (الفهم والإدراك الحصولي) بواسطة الاستدلال والبرهان، وأنّ الأصل المشترك في ميدان صراع العقل مع القلب هو الإيمان بالحقّ، فهو أصل مشترك بين الطرفين، وكلّ منهما يدركه، إلّا أنّ إدراك العقل حقّ ودقيق وواقع، ولكن إدراك القلب أكثر حقّانية ودقّة وواقعيّة، وتفصيل هذا الكلام في محلّه.
إنّ حادثة كربلاء العالميّة قد حدثت في ميدان الجهاد الأوسط، وقد حدث فيها صراع واختلاف حول الحقّ والباطل والعقل والهوى، وقد شارك في هذه الحرب والصراع الرجل والمرأة والبالغ وغير البالغ والمميّز وغير المميّز جميعاً، وعليه فمن لم يصل إلى سنّ البلوغ ولكن كان عنده القدرة على التمييز بين الحقّ والباطل فهو من الناحية العقليّة مكلّف، وإن كان من الناحية النقلية غير مكلّف، فالمميّز لو عرف الحقّ ولم يعمل به ـ لا سامح الله ـ فهو محاسب يوم القيامة بين يدي الله، ولا يحقّ لأحد أن يقول: إنّه مطلق العنان ما دام عمري أقلّ من خمس عشرة سنة، لوجود الفرق بين الأدلّة العقليّة والنقليّة، وبين الأمر العقلي والنقلي، وبين التمييز العقلي والنقلي، وكربلاء هي ميدان شارك فيه الرجل والمرأة والبالغ وغير البالغ المميّز، وأنّ نهضة كربلاء قد جعلت الرجل والمرأة والبالغ وغير البالغ المميّز حملة رسالة، إذن فرسالة نهضة سيّد الشهداء× على عاتق كلّ رجل لبيب وامرأة عاقلة؛ لأنّ دائرة الجهاد الأوسط لا تحتاج إلى السيف والرمح والسهم والسنان.
والغرض أنّ الجهاد على ثلاثة أنواع: الجهاد الأصغر والأوسط والأكبر.
ودرجات كلّ واحد من هذه الأقسام منوطة بسعي المجاهد، والغنيمة والغرامة الناتجة عنه.
فالجهاد الأصغر: غنيمته وغرامته قليلة، فمحاربة عدوّ يروم احتلال الأرض جهاد أصغر؛ لأنّ العدوّ إذا انتصر يتصرّف في الأرض على أنَّها غنيمته، وإذا انتصر الخصم فهو أيضاً يتصرف في الأرض على أنها غنيمته، أو أنّه ـ على أقلّ تقدير ـ يحافظ على أرضه. والأرض وشؤونها غير دائمة، والإنسان حينما يجتاز حدّ الطبيعة لن يأخذ معه شيء من تلك الأموال والأراضي.
الجهاد الأوسط: وهو درجة أعلى من الجهاد السابق، وغنيمة الفاتح في الجهاد الأوسط التواضع، والعدالة، والصدق، والزهد، والتقوى، وغرامة المغلوب في هذا الجهاد هي التكبّر، والخيانة، والكذب.
وأمّا الجهاد الأكبر: فغنيمته: التوحيد الخالص والشهود والخلافة الإلهيّة، وكمال الإنسانية، وغرامته: الحرمان من الفيض والفوز العظيم، فمن أراد أن يحظى بمنزلة عيظمة ويصبح معلّماً تستفيد من مدرسته الملائكة، فيجب عليه أن يجتاز هذا الطريق وهو الجهاد الأكبر، وهذا يعني أنّ كلّ تلك الثمار هي من الجهاد الأكبر. وقد ورد في بعض النصوص الدينية التعبير بأنّ الملائكة تضع أجنحتها تحت أقدام طلّاب العلم: «لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً به»[226].
وهذا العمل هو أوّل عمل تقوم به الملائكة، أمّا في قبال العالم الربّاني وخليفة الله فإنّ تلك الملائكة التي كانت في خدمة طالب العلم تصبح متعلّمة كما قال الله تعالى: (يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ)[227].
وبطبيعة الحال أنّ أصغريّة، وأوسطيّة، وأكبريّة الجهاد أمر نسبيّ، فيجوز أن يكون الجهاد أوسط بالنسبة إلى جماعة ولكنّه أكبر بالنسبة إلى جماعة أخرى، وهذا من قبيل الذنوب التي تتصف بالصغيرة والأصغر والكبيرة والأكبر عند مقارنة بعضها مع بعض، وأمّا إذا نسبناها إلى الذات الإلهيّة المقدّسة، فلا يوجد ذنب صغير؛ لأنّ الإنسان يخالف إلهاً لا مثيل له في الوجود، وقد قسّم المرحوم السيّد حيدر الآملي، وغيره من كبار أهل المعرفة الجهاد على أساس توزيع الغنيمة والغرامة ومقدارهما إلى الأقسام الثلاثة[228].
الكأس الثاني: العطاء العملي لكربلاء
الجرعة الأولى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المعروف هو ما يعرفه العقل والشرع، والمنكر هو ما ينكره العقل والشرع، ولا يحكم بصحّته. إنّ إلقاء المحاضرات والخطابة والوعظ وكتابة المقالات أمر سهل ومتاح للجميع، أمّا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يكون كلاماً صادراً من منطلق القوّة بحيث قد يصحابه شيء من الشدّة عند الضرورة فهو قليل جدّاً.
آنک یافت می نشود آنم آرزوست[229].
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعدّ عنصراً محوريّاً في رسالة النهضة الحسينية، وهي فريضة ثابتة على الجميع وفي كلّ زمان ومكان، وقد أبلغ الإمام الحسين× جميع الناس بهذه المهمّة، بأن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ولا يخفى اختلاف هذه الفريضة البالغة الأهمّية عن الخطابة وإلقاء المحاضرات والتعليم؛ وذلك لأنّ تعليم الجهلاء وإرشاد الغافلين تقع في مرحلة أسبق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي دوره حينما يرتكب الإنسان المعصية عالماً عامداً، عند ذلك يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر.
توضيحه: إنَّ القرآن الكريم يعدّ أحياناً بأمر ما، ويُتصوّر أنّ ذلك بيان لحكم أخلاقي، ولكنّه في آيات أخرى يأمر به، فعلى سبيل المثال أحياناً يقول: (إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)[230]؛ لأنّ السنّة الإلهيّة قائمة على إعطاء أجر الحسنة بعشرة أمثالها: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا)[231][232]. فالقرآن الكريم بداية يعدنا بالنصر بطريقة رحيمة ومشفقة، قائلاً: (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ)[233]. إلّا أنّ الأخلاق لا تنفع عند هجوم الأجانب الطامعين في دين الناس وأخلاقهم وقانونهم وثروتهم، لذا يلزم في مثل هذه الأجواء إجراء القانون؛ لأنّهم لو حرصوا على الأخلاقيات لما سمحوا للأجانب بالهجوم أبداً.
فحينما يعتدي الأجنبي تتحوّل الأخلاقيات إلى أوامر، ولذا قال الله تعالى في الآيات الأخيرة من سورة الصف التي تدور أغلب آياتها حول الحرب: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ)[234] فوجوب الجهاد وحفظ الدين لا يختصّ بكم، بل إنّه كان واجباً على المسيحيين أيضاً، وكذا الأمر في الصيام فإنّ وجوبه لا يختصّ بالمسلمين، بل هو ميثاق بين الخالق والمخلوق وكان واجباً على الأمم السالفة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ)[235].
إنّ دين عيسى المسيح ـ ذلك الدين المليء البركة والنورانيّة ـ كان ديناً ثوريّاً وجهادياً، وقد جعلوه اليوم ديناً علمانياً خالياً من الثورية والجهاد، والإسلام الأمريكي الذي ورد في كلام السيّد الإمام الخميني+[236] يعني هو الإسلام المتورّط بنفس العاقبة التي ابتلى بها الدين المسيحي، بناء على ذلك فنداء الإمام الحسين× «هل من ناصر» شبيه بنداء عيسى (مَنْ أَنْصَارِي)فحينما يقول عيسى روح الله (مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّه)[237] فهذا يعني: «هل من موحّد يخاف الله فينا، هل من مغيث يرجو الله بإغاثتنا»[238] ومن هذه الناحية يكون أبو عبد الله× وارث عيسى روح الله×.
فإذا أذنب المكلّف وجب نهيه عن ذلك الذنب؛ لأنّ أكثر الذنوب ترجع بالتحليل العقلي إلى الشرك، ومن هذه الجهة فالمؤمنون يمثّلون الأقليّة من بين الناس (أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ)[239].
وقال الإمام الصادق× في تفسير الآية الآنفة الذكر: «هو الرجل يقول: لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لأصبت كذا وكذا، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنّه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه ويدفع عنه؟ قال: قلت: فيقول: لولا أنّ الله منّ علىّ بفلان لهلكت؟ قال: نعم، لا بأس بهذا»[240].
والعبارة المتداولة على ألسن عامّة الناس «أعتمد على الله أوّلاً وعليك ثانياً» غير صحيحة؛ لأنّ الله ليس أوّلاً حتّى يكون له ثان: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ)[241] وغير الله ليس ثانياً له، وإنّما جنوده ومظاهر قدرته، فينبغي تحاشي هذا التعبير حفاظاً على التوحيد وعلى وساطة تلك الأمور معاً، وهذا واجبنا الشرعي.
وقد جاء في الأحاديث النبويّة أنّ الإنسان إذا لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس...»[242] وقد ورد عن الإمام الرضا×: «من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكر الله »[243][244].
ینبغي التوسّل بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعمل على منع وقوع الذنوب والمعاصي، ولا ينجر الأمر بالناس إلى السلطات القضائيّة؛ لأنّ القضاء إن رام معاقبة المجرم وتنفيذ قانون خاص بشأن ما ارتكبه سيُعترض على القضاة بعدم التنبيه، على أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتجنّب الوقوع بالذنب ودفعه، ولذا يمكن أن يُعترض عليه بدرجة أقلّ.
ونتيجة هذا البحث هي أنّ الإمام الحسين× أشبه في استنصاره واستغاثته ما جاء في آيات القرآن الكريم من استنصار واستغاثة، وما زال نداؤه× يتردّد في أرجاء العالم داعياً إيّانا لنصرة الله ودينه، ورسالتنا أن نعرف دين الله تعالى ونعمل به وننشره.
قال أمير المؤمنين×: «وإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل، ولا ينقصان من رزق»[245] «لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولّى عليكم شراركم، ثمّ تدعون فلا يُستجاب لكم»[246].
وقال أمير المؤمنين×: «فإِنّ الله سُبحانه لم يَلْعنِ القرن الْماضيَ بيْن أَيديكم إِلَّا لِتركهِم الأَمر بالْمَعرُوف والنَّهي عنِ المنكرِ»[247] وبناء على هذا فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلهي ومن الفرائض، يجب العمل به وحثّ الآخرين عليه كذلك.
إنّ رسالة النبي الأكرم’ إلى المجتمع الإسلامي هي أنّه لا ينبغي لأيّ فرد أن يقول: «لا يعنيني» أو «ما شأنك وما يعنيك» غافلاً عن حيثيّته الاجتماعيّة؛ لأنّه بالرغم من صعوبة إثبات وجود متميّز للمجتمع غير وجود الأفراد، إلّا أنّ الحيثيّة الاجتماعيّة ثابتة لكلّ فرد، فالإنسان كما له حيثيّة فرديّة لديه حيثيّة اجتماعيّة ـ أيضاً ـ تمثّل ارتباطه بالآخرين، ومن باب تشبيه المعقول بالمحسوس جاء تشبيه النبي’ لأفراد المجتمع كراكبي سفينة ستحلّ الكارثة بهم جميعاً إذا ما واجهت خطراً ما، فلو أراد أحد المسافرين خرق السفينة، واعتبر السذّج من الناس هذا الفعل من حقّه، وسمحوا له بذلك فستمتلئ السفينة بالماء وتغرق ويُقضى على الجميع. وأمّا لو لم يسمحوا له بذلك وكضوا على يديه، فسيصل الجميع إلى برّ الأمان: «فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا، وإن لم يأخذوا على يديه هلك وهلكوا»[248].
فالحسين× قد نهض لأقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولطالما أكّدها خلال نهضته. إذن هذه الفريضة العظيمة والخطيرة هي رسالة الأمّة الإسلاميّة.
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب، واهمّها ما يتكفّل به الجهاز الحاكم، وأمّا المراتب الأخرى منه كالاعتراض على منكر أو الأمر بمعروف فهي على عاتق الشعب والأمّة.
الأمر بالمعروف ـ كما تقدّم ـ يختلف عن الحدّ والتعزير والتي هي إجراءات قضائيّة؛ لأنّه فی الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر یُمنع المكلّف من ارتكاب الذنب، فإذا لم يحجزه ذلك عن ارتكاب المعصية يأتي دور الحدّ في قسم منها والتعزير في قسم آخر، والمتصدّي الوحيد لذلك هو الجهاز القضائي.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتطلّب أحياناً الصدام، وقد ينجم عنه بعض الإصابات، فيلزم من أجل ذلك التخطيط واتخاذ التدابير، ولهذا فتحقيق هذه الفريضة مرهون بإرادة الشعب وصبره وتحمّله: (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ)[249] وعزم الأمور، يعني أنّ ذلك من الأمور التي يجب أن يعزم عليها أو ينبغي أن يعزم عليها.
جاء في الحديث: «تخلّقوا بأخلاق الله»[250] والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نموذج واضح من أخلاق الله، ولذا ورد: «إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخَلقان من خلق الله سبحانه»[251].
ولا تُعدّ تلك الآيات التي تحثّ على التعليم والإرشاد والهداية والموعظة كقوله تعالى: (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)[252] وقوله : (مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ)[253] وقوله: (وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا)[254]، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنّما قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)[255] يندرج ضمن الآيات الدالّة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق الإلهيّة المرتبطة بمحور هذا البحث.
إنّ مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبدأ بالاستنكار القلبي للذنب، ثمّ منع المذنب باللسان، وأخيراً منعه بالعمل، والمرحلة الثالثة هي أعلى مرتبة لأداء هذه الفريضة.
فمن لم يتمكّن من أداء المرحلة الثالثة، يجب أن يلتزم بأداء المرحلة الأولى والثانية، وإن لم يقدر على أداء المرحلة الثانية، فلا أقلّ من الإتيان بالمرحلة الأولى وهي الاستنكار القلبي، وأمّا إذا ترك امتثال هذه الفريضة بجميع مراحلها فهو ميّت بين الأحياء: «فذلك ميّت الأحياء»[256]، وبناء على هذا فالناس على أربعة فئات، فئة الأموات الأحياء، والأحياء وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويمثّلون الفئات الثلاثة المتبقّية.
إنّ أمير المؤمنين× يرى أنّ الجهاد له شعب ودعائم أعظمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومراحله العليا أفضل من الدنيا، ولذا قال أمير المؤمنين× في كلماته القصار: «وما... الجهاد فِي سبِيلِ اللَّه ـ عِند الأَمرِ بِالْمَعروف والنهيِ عن الْمُنكرِ ـ إِلَّا كنفْثَة فِي بحرٍ لُجِّيٍّ»[257]. وهذا جانب من السيرة العملية لسيّد الشهداء× حيث أطلع أصحابه على هذه السنّة وعرّفهم بهذه السيرة.
إنّ الإمام الحسين× قد فسّر الثقافة الدينيّة الغنيّة والرصينة وطبّقها، مبيّناً معنى الحياة والحكمة والبصيرة، وكاشفاً عن أسباب نهضته، موضّحاً للجميع أنَّ الحقّ لا يُعمل به والباطل لا يُتناهى عنه، وهناك قوم عادَوا الدين عن قصد، وفي مثل هذه الظروف والأوضاع لا يبقى خيار غير الثورة والتضحية بالدماء: «ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به وإلى الباطل لا يُتناهى عنه... فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برماً»[258].
إنّ موسى الكليم× قد اتخذ البرهان والاستدلال والمجادلة والمناضرة بالتي هي أحسن وسيلة لأداء رسالته ولم يستخدم أسلوباً آخر: (فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)[259]، ولكن لما وجد أنّ هذه الوسيلة لم تعد مؤثّرة استعان بوسيلة أخرى، فحمل العصا واتخذ سبيل الكفاح والمواجهة، قال تعالى: (فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ)[260](وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ)[261].
ومعنى كلام سيّد الشهداء أنّ الناس في هذا الزمان لا يُتناهون عن المنكر ولا يُقيمون له وزناً ولا حرمة، والحياة في مثل هذه الظروف والأجواء مملّة ومؤسفة تُتعب الإنسان الحرّ اللبيب، ولهذا فإنّي لا أرى الموت في هذه الظروف إلّا سعادة، وكلّ من يحمل فكري يختار هذا الطريق ولا يهاب الموت.
وقال سيّد الشهداء×: «وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي»[262] والذي يريد الإصلاح لا يكتفي بالتمسّك بالقرآن الكريم، بل لا بدّ له من (التمسيك)، والتمسيك من باب التفعيل وهو يدلّ على الشدّة والمبالغة، فمن أراد الحفاظ على نفسه كالعابد المتنسّك فهو من أهل التمسّك بالقرآن الكريم، ولكن من يريد المحافظة على الآخرين من خطر الذنوب والمعاصي، يجب عليه أن يكون من أهل التمسيك بالقرآن الكريم، فأهل التمسيك لا تزلّ أقدامهم ولا يحرفهم شيء، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ)[263].
الجرعة الثانية: تأسيس النظام الإسلامي
أعلن سيّد الشهداء× في وصيّته هدفه المنشود من نهضة كربلاء: «أسير بسيرة جدّي وسيرة أبي علي بن أبي طالب»[264] وسيرة أمير المؤمنين× سيرة رسول الله؛ لأنّ علي× نفس النبي| وسيرة رسول الله کانت وفقاً للهداية الإلهية على صراط مستقيم، لقوله: (إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)[265] فلا بدّ أن نستنبط سيرة الإمام× من القرآن الكريم:
توضيح ذلك: إنّ الله} يُخبر رسوله بانّه أنزل القرآن الكريم كي يخرج المجتمع البشري من الظلمات إلى النور، قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ)[266] وعليه فقيام الناس بالقسط والعدل (لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)[267] إنّما هو هدف متوسّط وليس الهدف الأخير، إذ إنّ الهدف الأخير هو نورانيّة المجتمع؛ فمتى ما أصبح نورانيّاً سيقوم بالقسط والعدل، فأهل القسط والعدل يتصفون بالنزاهة والصلاح، ومع ذلك قد لا يبلغون مقام النورانيّة الشامخ؛ لأنّ النور العقلي غير الحسّي وهما غير النور الذاتي، والهدف الأخير هو نورانّية الإنسان والخروج من كلّ ظلامية وضلال.
القرآن الكريم كتاب بيّن، ولا يمكن أن يأمر بقضيّة دون أن يوضّح السبيل إليها وكيفية التفاعل معها، ولذا لما أراد بيان كيف يصبح المجتمع نورانيّاً، أتى على ذكر ثورة موسى الكليم× بعد هذا واستنطقه، مؤكّداً حقيقة هي أنّ الطريق لنوارنيّة الناس تكمن في تأسيس حكومة إسلامية. وإن امتاز عالم الطبيعة بخصوصية هي أن لا شيء فيه يخلو من الخسائر، وليس هناك عالم خال من الحقد والعداء والنزاعات سوى الجنّة: (لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ)[268] و(وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ)[269]. أمّا لو تمّ تأسيس نظام إسلامي حينها سيتعرّف أكثر الناس على الخصائص الإلهيّة، رغم وجود سلسلة من الصعوبات المستبطنة في العالم التي لا يمكن الوقاية منها، وهذا ما حصل لموسى الكليم عندما كلّف من قبل الله} بإخراج الناس من الظلمات إلى النور بالثورة على فرعون، وفي نهاية المطاف تمّ تأسيس النظام الإسلامي في مصر بمقاومة وصمود موسى وأتباعه، وعلى إثر ذلك أُلقيت هيمنة آل فرعون السلطوية في البحر (فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ)[270](فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ)[271]. وكذا تمّ إلقاء السامريين الدجّالين في النار (لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا)[272].
استناداً إلى كتب أبي عبد الله الحسين× وكلماته وخطبه يتبيّن أنّ هدفه إحياء الدين، وإحياء الدين يتحقّق من خلال تأسيس النظام الإسلامي، وهذا يتطلّب التضحية بالمال والنفس، ولذا ركّز الإمام× في وصيّته على أنّ سيرتي هي سيرة جدّي وأبي÷، وسيرة رسول الله’ هي القرآن الكريم؛ لأنّ رسول الله’ هو المفسّر العلمي والمطبّق العملي للقرآن الكريم، وبناء على هذا فإنّ خطّته وثورته قد نظّمها ودوّنها القرآن الكريم وأوضح طريق الوصول إليها، وهذا يعني أنّه كما حثّ القرآن الكريم على الصلاة والحجّ وجسّدهما النبي الأكرم’ خارجاً بقوله للناس: «خذوا عنّي مناسككم»[273] و«صلّوا كما رأيتموني أُصلّي»[274] كذلك الجهاد يحتاج إلى تجسيد خارجي كي يستطيع المجسّد للجهاد أن يقول للآخرين: «خذوا عنّي جهادكم» وهذا ما قدّمه الإمام الحسين× من تجسيد وتمثيل عيني في مجال الجهاد، بالرغم من أنّ الرسول الخاتم قد سبقه في تقديم رسم بياني جيّد لذلك.
إنّ أهمّ عامل في الجهاد والدفاع المقدّس، هو أن يرى الإنسان دينه أغلى عليه من نفسه، وحياة الدين أحبّ إليه من حياته الدنيويّة، وتحقّق الإيمان بهذه العقيدة ليس أمراً سهلاً، ولذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ...)[275]. والقرآن الكريم كما يوضّح أساس الفكرة في سورة التوبة ويبيّن أنّها مبدأ عامّ كذلك يطلق عنوان (حزب الله) في سورة المجادلة[276] على الثابتين على هذا المبدأ والمتصفين بهذه الصفة كي يرى الآخرون، ويعلموا جيّداً أنّ الإنسان بإمكانه أن يعيش حياة يكون فيها دين الله أحبّ عنده من زخارف الدنيا المتمثّلة بحبّ الأب والأخ والزوجة ومحلّ العمل وغيرها، والإيمان بهذا الأمر ليس من وظائف العقل النظري الذي يصدّق بالشيء بعد تصوّره، بل من وظائف العقل العملي، یعنی لا بدّ من الميل إلى ذلك والعزم عليه.
شروط انتصار النهضة
إنّ السبيل لإخراج المجتمع من الظلمات إلى النور ـ طبقاً لما دعتنا إليه التعاليم القرآنية ـ هو ما سلكه موسى الكليم لهداية الناس علميّاً وعمليّاً، فقد خاض حرباً مع الفراعنة والسامريين، وأحرق الفكر الإلحادي المتمثّل بعبادة العجل، ونسف فرعون وجبروته في اليمّ نسفاً[277]. الإمام الحسين× لم يقتصر في كتبه التي أرسلها إلى أهل الكوفة على ذكر التوحيد والمعاد والأسماء الحسنى، بل ركّز على مسألة مصيريّة ومهمّة ترتبط بواقع الحال، وهي حاجة الناس إلى الإمام[278].
إنَّ الوظيفة الأساسية للإمام والقائد هي تبيين مقوّمات الدين وشروطه وأركانه، وأمّا الحياة المقتصرة على الأكل والشرب واللّبس، فإنّها لا تختصّ بالحيوانات فحسب، بل النباتات أيضاً، فالذي يأكل بصورة سليمة وينام جيّداً ويرتدي ملابس حسنة فإنّه يمتلك حياة نباتية ويُعدّ نبتة جيّدة، لكنّه لم يبلغ حتّى الآن مرتبة الحيوانية على حدّ تعبير ابن سينا[279] فضلاً عن مرتبة الإنسانية؛ لأنّ الغذاء والنموّ والتكاثر صفات متوفّرة في النبات أيضاً، وأمّا الذين امتلكوا العواطف والأحاسيس والطموحات دخلوا حدود الحيوانية، والذين جعلوا الأوهام والخيالات تحت أقدامهم ارتقوا إلى مرحلة الإنسانية، وهذا التقدّم والارتقاء يستمرّ حتّى لقاء الله، ويستحيل قطع هذا الطريق دون قائد فقيه، ولذا أكّد سيّد الشهداء× في كتابه الذي أرسله للشخصيّات العلمية في الكوفة على عظمة وخطر منصب الإمامة والقيادة، مبيّناً شروط الإمام وأوصافه[280].
إنّ الكتب التي أرسلها أهل الكوفة إلى سيّد الشهداء× لم تشتمل على مضمون واحد، فجاء في بعضها: «... فقد اخضرَّ الجناب وأينعت الثمار وأورقت الأشجار، أقدِم إذا شئت فإنّما تُقدم على جُندٍ لك مجنَّدة»[281]، ولكن الإمام× لم يُعر أهمّية لمضامين هذا النوع من الكتب، وإنّما كانت أجوبته تلفت نظرهم إلى المعارف السامية كقوله: «فلعمري ما الإمام إلّا العامل بالكتاب الآخذ بالقسط والدائن بالحقّ والحابس نفسه على ذات الله والسلام»[282] فيجب من وجهة نظر الإمام الحسين× أن يكون الحاكم قائماً بالقسط، أي يكون ثابتاً على مبادئ القسط والعدل. والمهم هو الثبات ، وليس معنى القيام هنا بمعنى الوقوف كما في قوله تعالى: (أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى)[283] فمن لا يمتلك البنية التحتيّة للقسط والعدل فهو قاعد، وإن كان واقفاً من الناحية الجسميّة والظاهريّة، وإذا ازداد الخطر السياسي والاجتماعي أصبحا أكثر شدّة، فلا يكفي في معالجته أن يكون الإنسان قائماً بالقسط، بل لا بدّ أن يكون قوَّاماً بالقسط كما ورد تأكيده في القرآن الكريم مراراً، أي: يجب أن يكون من أهل الثبات والمقاومة بحيث يقوى على قمع كلّ باطل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ)[284].
ثمّ قال: «ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب... والدائن بدين الحقّ، الحابس نفسه على ذات الله»[285].
فكان سيّد الشهداء× يؤكّد حقيقة قرآنية، وهي أنّ الله تعالى ناصر دينه وموهن كيد الكافرين، وإن لم نقم بنهضة نصرةً له، سيقوّض الله رجالاً يحملون راية الدفاع عن دينه؛ لأنّ الله سبحانه يهدي جميع الموجودات إلى كمالها المناسب، والإنسان غير مستثنى من هذا القانون، بل هو على رأس تلك الموجودات، والإنسانية لا تبلغ الكمال إلّا عن طريق تأسيس النظام الإسلامي. إنَّ أمير المؤمنين× بناء على كلام رسول الله’: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة»[286] قد أسّس نظاماً قائماً على الحقّ، فمن التزم بالصلاة والصيام والزكاة والخمس، ولم يعرف إمام زمانه فهو جاهل بالرغم من عبادته وزهده، وينطبق عليه عنوان الجاهليّة الوارد في الحديث «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة»[287].
والسيّدة فاطمة الزهراء‘ حينما رأت انزواء الإسلام العلوي وسيادة غیره، أخبرت بأنّ الأمّة تعيش في جاهليّة وضلال؛ لأنّها لم تعرف إمام زمانها علي بن أبي طالب وتركته جليس البيت، فكلّ من يدّعي الخلافة ويقف أمام علي× ويؤسّس حكومة فحكومته ونظامه تجسيد حقيقي للجاهليّة، ولذا أعلنت الزهراء‘ عن موقفها في المسجد وأمام الناس وأمام من ادعى الخلافة، وأخبرتهم برجوعهم إلى الجاهليّة، وابتغائهم حكم الجاهليّة، إذ كان من المفترض أن يرجعوا إلى إمامة علي× وابتغاء حكمه العادل، ليحظوا بنظام إسلامي وحكومة عادلة[288].
وقوع هذا الانحراف كان في بداية الإسلام، وجاءت أحداث واقعة كربلاء امتداداً لذلك الانحراف ومن نتائجه (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)[289].
حينما قال الحارث بن الحرّ للإمام علي×: نريد أن نكون كسعيد وعبد الله بن عمر ونعلن عن الحياد، نهاه الإمام عن هذا العمل، قائلاً: «إنّ سعيداً وعبد الله بن عمر لم ينصرا الحقّ ولم يخذلا الباطل»[290] والحياديّة عند الحرب بين الحقّ والباطل دليل على السفاهة، فالإنسان الحكيم يميّز بين الحقّ والباطل، ويشخّص المبطل من المحقّ، ويسلّ سيفه دفاعاً عن الحقّ من أجل القضاء على الباطل.
وقال الإمام الحسين× مثل هذا الكلام لعبيد الله بن الحرّ الجعفي في طريق كربلاء، محذّراً إيّاه عن الحياد في الحرب؛ لسفاهة الحيادي والمتفرّج في حرب قامت بين العدل والظلم.
ولمّا نزل أبو عبد الله الحسين× بالقرب من خيمة، سأل عن صاحب تلك الخيمة، فقالوا: هي لعبد الله بن الحرّ الجعفي، فأرسل رسوله إلى الجعفي يُخبره بأنّه بين الحقّ والباطل، وعليه أن ينصر الحقّ المتمثّل بنصرة الحسين×. فقال عبد الله: إنّي إنسان محتاط ورأيت الكوفة على خطرين، فقلت في نفسي: إن نصرت الحسين× فدنياي في خطر، وإن نصرت الأُمويين فآخرتي في خطر، ولذا خرجت من الكوفة إلى هذا المكان، ولكنّي سأُقدّم دعماً مالياً للإمام الحسين×، وأقدّم له فرسي وسيفي ودرعي ورمحي.
فلمّا وصل الخبر إلى الإمام الحسين× قال سأذهب إليه شخصيّاً لعلّ الهداية تدركه، يقول عبد الله الجعفي: بالرغم من التأثيرات العاطفيّة التي هزّت جميع كياني لكنّي أجبته بنفس الجواب الذي أجبت به رسوله، فلمّا سمع الإمام× جوابي تلى هذه الآية: (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا)[291][292].
وطبعاً لم يكن الإمام الحسين× يطلب المساعدة لنفسه شخصيّاً، ولذا قال لأصحابه في أصعب ليلة وهي ليلة عاشوراء: «ألا وإنّي قد أذنت لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ، ليس عليكم منّي ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً». وأبرز حينها أصحابه تفانيهم ووفاءهم له[293]، فلم يكن همّ الإمام الحسين× یومها جمع أكبر قدر من العدد والعدّة، بل غايته نجاة الإنسانية، وهكذا قائد هو اللائق بتشكيل الحكومة الدينيّة، فقال الإمام×: لو بقيتم في بيوتكم ولزمتم الحياد فإنّ الذين مصيرهم الشهادة سيبرزون إلى مضاجعهم وينصرون دين الله من خلال التضحية بدمائهم، (لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ)[294].
ولما اقتُرح على أبي عبد الله× ترك الإصرار على هذه الثورة غير المتكافئة، ردّ بأنّ الله} قد ابتلى به هذه الأمّة، فهو محور الاختبار الإلهي، وإذا لم ينهض بهذه الثورة كيف سيمتحن الله تعالى هذه الأُمّة، ولا يمكن اختبار الأمّة بابن الزبير ولا غيره؛ وهذا الكلام لم يصدر من الإمام× من باب المديح لنفسه، إنّما كان الغرض منه ذكر النعم التي حباه الله بها (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)[295]، وحينما تُطرح التساؤلات على الإمام×: لِمَ لا تستفيد من القوى الغيبيّة للقضاء على الفجرة المجرمين لا سيّما وأنّ الله قد أعطاك الولاية التكوينيّة والقدرة على الإعجاز، وقد أبدت الملائكة والجنّ وغيرها استعدادها لنصرتك، فلماذا لم تسمح لهم بنصرتك؟ فأجابهم الإمام×: لا ضرورة لاستخدام القوّة الغيبيّة، فغرضي تفهيم الناس وتنويرهم بالاستدلال والبرهان كي نكون قد ألقينا الحجّة على من أراد قتالنا ومحاربتنا؛ لأنّ معاقبة الإنسان أو مكافأته لا تصح قبل إقامة الحجّة عليه: (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)[296]، ولذا نجد كلّ خطابات الإمام الحسين× واحتجاجاته وكلماته كانت تتمحور على أساس القرآن الكريم والسنّة القطعيّة للنبي الأكرم|.
وقد كتب كتاباً خاصّاً لبني هاشم، قائلاً: «أمّا بعد، فإنّه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلّف عنّي لم يبلغ الفتح، والسلام»[297] إذن فالشهادة فتح وانتصار، ومن أراد ذلك فليلتحق بي، فلا يُنال الفتح بالسكوت والسكون، والقعود والتخلّف، بل يُنال جميع ذلك بالثورة ضدّ الباطل والظلم، ویجب أن تكون بمحوريّة الإمام العادل؛ لأنّ الإمامة نظام الأمّة، وعهد الله، والانسجام والتلاحم لا يمكن دون العهد الإلهي.
المواجهة بين القيادة العلويّة والقيادة الأُمويّة
قد وقف الإمام الحسين بن علي÷ بوجه الإسلام الأُموي، كما كان أمير المؤمنين× قد وقف بوجهه، فمعاوية الذي كان يريد أن يحارب علياً× لا يتمكّن من محاربته بالمنحى الذي كان عليه قبل فتح مكّة، بل لا بدّ أن يحارب الإسلام العلوي بغطاء الإسلام الأُموي، ولذا كانت الكتب العلويّة والأُموية متقاربة، ولا يتمكّن من استشمام رائحة كتاب علي× وتشخيصه عن غيره إلّا أهل الفصاحة والبلاغة، فلم يكن التمييز بين كتب علي× ومعاوية ميسّراً لغير أهل اللغة والأدب؛ لأنّ كتب الأُمويين امتلأت بالدعوة إلى عبادة الله تعالى، واجتناب الذنب، والحذر من جهنّم، والوصيّة بالزهد والتقوى، وترك الدنيا، وكأنّما أجازوا لأنفسهم أنْ ينصحوا قسيم الجنّة والنار ويحذّرونه من جهنّم[298].
وقد حارب العبّاسيون الأئمّة المعصومين^ بنفس هذه الطريقة، ولم يتسنَّ للمنصور الدوانيقي أنْ يحارب الإمام الصادق× بلباس الكفر، بل إنّ العبّاسيين قد حاربوا الإمام الصادق× وبقيّة الأئمّة^ بلباس الإسلام العبّاسي[299].
وقد لاحظ سيّد الشهداء× أنّ خداع بني أُميّة قد أصبح أمراً قطعيّاً، وأنّ هذه الخديعة والمكر لا يمكن إزالتهما إلّا بالدماء، ولو أنّ الحسين× ثار في المدينة واستشهد فيها لما انتشرت نهضته في الشرق الأوسط لا سيّما في ذلك العالم الذي كانت فيه وسائل الإعلام بدائيّة، ولذا ثار الإمام الحسين× بحسب التخطيط الإلهي، واستطاع هو وأهل بيته أن يبيّنوا للأمّة الإسلامية على نطاق واسع أنّ الإسلام الأُموي غير الإسلام العلوي.
إنّ الصبر والثبات ـ مضافاً إلى القائد الإلهي ـ أمر لازم لنيل الانتصار، وقد حقق الله سبحانه الانتصار في دعوة موسى وثورته من خلال القيادة الإلهيّة المتمثّلة بالكليم موسى× ومن خلال الصبر والثبات عن طريق التذكير بأيّام الله تعالى، وأيّام الله تعالى هي تلك الأيّام التي ظهرت فيها قدرة الله}، واستتبت فيها الحكومة الإسلاميّة للصالحين: (لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)[300](وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ)[301]، وبناء على هذا، فلو لم يصمد الإنسان في الحرب مع الطغاة وفقد صبره وتحمّله فلا يمكنه بلوغ الهدف، ولو انتصر وتوهّم أنّ ذلك الانتصار غنيمة ماديّة قد حصل عليها بجهده وخططه وإليه يعود الفضل في ذلك، فلا يُعدّ شاكراً، فبعد الانتصار يجب الشكر كي يستقرّ النظام الإسلامي ويبقى ثابتاً، وشكره أن يعتقد الإنسان ويذعن بأنّ النعمة من الله والاستفادة منها قدر المستطاع بالشكل الصحيح، ولا يغترّ أبداً.
إنّ الله أشار في القرآن الكريم إلى حقيقة وهي أنّ الله تعالى حينما يُهلك عدوّكم ويستخلفكم في الأرض حتّى يستتبّ لكم الحكم، فليس ذلك من قبيل الاستحقاق والجزاء، أو لأنّكم جديرون بالحكم، بل هذا الاستخلاف من باب الاختبار كي ينظر ماذا تعملون. إن أعطيناكم قوّة وسلطة فالغاية من ذلك الاختبار لنرى ماذا تصنعون، فإن تجبّرتم وعصيتم أهلكناكم، واستبدلناكم برجال صالحين، وإن أصلحتم زدناكم قوّة وبأساً، وكما كنتم صبورين قبل الانتصار فكونوا شكورين بعده: (عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ)[302]، (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)[303](لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)[304].
نعم، الصبر بمفرده لا يكفي لمحاربة فرعون وتشكيل النظام الإسلامي وعدم الوقوع بفتنة السامري، بل لا بدّ أن يكون الإنسان صباراً، وبعد الانتصار لا يكفي الشكر وحده للحفاظ على معطيات ومنجزات ذلك الانتصار، بل لا بدّ أن يكون الإنسان شكوراً.
إذا استقرّ النظام الإسلامي فستكون أبواب الجنان مفتّحة، وأبواب النيران مغلقة، كما هو الحال في شهر رمضان المبارك، وفي مثل هذا النظام تُفتح أبواب عبادة وطاعة الله تعالى على الإنسان وتغلق أبواب الذنوب، وهذا يعني من أراد أن يكون من أهل الزهد والتقوى والقسط والعدل فالطريق مفتوح، ومن أراد الذنوب والمعاصي فلا بدّ أن يمرّ عبر منعطفات وطرق ملتوية وصعوبات كثيرة.
وهدف سيّد الشهداء× هو تشكيل هذا النظام، ولذا كان× يحثّ الناس في خطبه وكلماته وكتبه على ترك التعلّق بالدنيا والاشتياق إلى الشهادة والخلود، وإحياء ذلك في قلوبهم، حتي يتمكّن الناس من أن يكونوا صبورين شكورين، يثورون على الأُمويين. ولذا كان يركّز أحياناً على الحقيقة التي نطق بها القرآن الكريم: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ) فإن لم يمت الإنسان موتة عزيزة كريمة سيموت موتة غير عزيزة، واذا لم يكن طيباً طاهراً فسيكون ميتاً.
عمر الإنسان کثمرة انبثقت من الطبيعة، فإذا نضجت هذه الثمرة وأصبحت لها قيمة فلا ينبغي ترك الانتفاع بها، ولا ينبغي عدم إهدائها إلى صاحبها الأصلي؛ لأنّها لو لم يتمّ التضيحة بها في سبيل الله ستفسد وتتلف بلا فائدة، والموت يدرك الإنسان ولو كان في قصر مشيّد ورصين: (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ)[305].
ج ـ الثورة ومنهج الإصلاح العام
إنَّ النبي الأكرم’ جاء بدين تجاوز الجوانب العباديّة والفرديّة إلى الحدود والقصاص والتعزيرات والعلاقات الدوليّة وما أشبهها، كذلك كانت ثورة سيّد الشهداء× شاملة لجميع هذه الأبعاد، ولذا أعلن في وصيّته: «إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدي»[306]، وإصلاح الأمّة لا يتحقّق دون محاربة الفساد والظلم؛ لأنّ الأشرار والطواغيت لا يخالفون القادة الإلهيين على المستوى النظري والقولي، ولكن حينما يتحوّل الموضوع من قضايا نظرية إلى قضايا خارجيّة، ويصبح عائقاً أمام منافع فئة منهم، فإنّهم سيقاتلون الأنبياء ويقفون بوجه نهضتهم ويحاربونها.
وعلى هذا الأساس، ورد التعبير في القرآن الكريم: (وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ)[307] تارة، وأخرى (وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ)[308]، حيث يذكر الأنبياء بالجمع المحلّى بالأف واللام، وهذا يعني أنَّ المعاندين للحقّ تمرّدوا وقتلوا كثيراً من الأنبياء، وتدلّ هذه التعبيرات على احتدام حرب وصراع، ثار فيها الأنبياء ونال الكثير منهم الشهادة، إذ قلّما يُشهر السيف بوجه المُكتفي بالنصح والوعظ، وأمّا لو ثار المنادي بالعدالة ودعا الناس إلى العقل والعدل، وصار معارِضاً لمصالح المتسلّطين، وأخذ يُبيّن الحلال والحرام معتقداً أنّ تنفيذها بحاجة إلى الحدود والتعزيرات، فهنا يبرز التصادم والصراع ويقع القتال والشهادة، ولذا يؤكّد الله سبحانه على أنّه لولا قانون الجهاد والدفاع لعمّ في الأرض الفساد، وتهدّمت مراكز الدين كالمساجد والكنائس والصوامع ومعابد الرهبان: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ)[309](وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا)[310].
هاتان الآيتان ذكرهما القرآن الكريم ليبيّن عظمة حقّ الدفاع، فمضمون الآية الأُولى: أنّه لو لم يوجد الدفاع لعمّ الفساد وانتشر، والآية الثانية تبيّن لنا حقيقة وهي: إذا عُطّلت مراكز الدين وبقيت مؤسسات إصلاح المجتمع معطّلة انتشر الفساد، والنتيجة هذه المرّة لا تختصّ بالإسلام، وإنّما تشمل جميع الأديان والتي هي الإسلام بعينه، ولذا لا يوجد دين ليس من دعائمه الدفاع عن المقدّسات[311]، وكما خاطب الله} المسلمين، وقال لهم: كونوا أهل حرب وقتال كالمسيحيين، وقوموا للدفاع عن دينكم : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ)[312] وهذه الآية تُثبت وجود الجهاد الدفاعي في الإنجيل ودين المسيحيّة.
ثمّ تأتي الآية الأخرى لتفصّل الحديث عن أصل القتال والجهاد الدفاعي، حيث تقول: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ)[313] وهذا يعني أنّ اللهاشترى أنفس المؤمنين وأموالهم، والمؤمن لا يتصرّف بنفسه وأمواله تصرّفاً غصبيّاً، فمن تصرّف بنفسه وأمواله بما يتوافق مع أهوائه، أو لم يبايع الله تعالى، ولم يشرِ نفسه وأمواله لله فهو ليس بمسلم، ومن باع نفسه وأمواله لله ولكنّه تصرّف فيهما تصرّفاً غصبيّاً فحياته كلّها غصبيّة، فلو فرَّ الجندي الذي يجب أن يكون حاضراً في ساحات القتال فجميع حياته غصبيّة تنفّسه للهواء وأكله للطعام واستراحته؛ لأنّ النفس والمال يجب استخدامهما فيما أجازه المالك الحقيقي وهو الله}، وهذا الكلام لم يرد في القرآن الكريم وحسب، بل قد ورد في التوراة والإنجيل، وقد أوصى موسى الكليم وعيسى المسيح بذلك[314]، بل هذا ما أوصى به جميع الأنبياء؛ لأنّ الأنبياء لم يقتصروا على بيان الحكم الفقهي والأصولي والفلسفي، إنّما تكفّلوا بإصلاح جميع المجتمعات البشريّة بكلّ مجالاتها، وكانوا يهتمّون أيضاً بالجوانب الثقافية وغيرها، ولديهم وجهات نظر تجاهها، والجهاد الدفاعي ـ بلا شك ـ كان من أهمّ الأمور التي يعتمدون عليها في خطّتهم الإصلاحية؛ لأنّ المجتمعات البشريّة ليست ملائكة لا تسفك الدماء ولا يعتدي بعضها على بعض، فالبشر لديه القابلية والاستطاعة على الاعتداء، ولا بدّ من إيقاف اعتدائه عند حدّه، وإلّا فلا يمكن إقرار الرفاه والأمن، وإصلاح المجتمع، والحدّ من التجاوز والاعتداء دون عقوبة وتعزير، والقانون الذي يمنع الاعتداء هو القانون الإلهي فحسب[315].
وكما تقدّم لا يوجد دين في غنى عن الجهاد في سبيل الله، والنظام العسكري، والأديان المشهورة في العصر الحاضر هي عبارة عن المسيحيّة واليهوديّة والإسلام، وهي امتداد لدين إبراهيم الذي كان يحمل الاستدلال والفأس؛ لأنّه لا الفأس مؤثّرة من دون الملكوت، ولا الملكوت مؤثّر من دون فأس: (وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ...)[316](لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ...)[317].
إنّ أفراد المجتمع هم عبارة عن فرقتين: فرقة صالحة ومصلحة، وفرقة فاسدة ومفسدة، وهناك من الفرقة الثانية من يتستّرون على ذلك بحسن الظاهر، ويتحدّثون عن الله وعن رسوله’، ويحترمون المقدّسات الدينيّة، ويكرّمونها، ويقسمون بتلك المقدّسات على أنّ كلامهم حقّ، ولكنّهم ألدّ الأعداء، يدّعون أنّهم مصلحون، ولكنّهم هم المفسدون في الأرض، يتظاهرون بالدعوة إلى عبادة الله، وهم أسوء المنافقين والمشركين، يتسبّبون بالأضرار للزراعة وتربية الحيوانات وحياة الناس والبيئة، ولا يمكن إصلاحهم بالموعظة، وإذا دعاهم أحد إلى التقوى تأخذهم العزّة بالإثم، ولا يصغون لمن يعظهم، فيقفون بوجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ)[318].
وإذا عاثت هذه الطائفة فساداً في الأرض خلق الله أشخاصاً مجاهدين مضحّين ـ بمقتضى رحمة الله تعالى ورأفته ـ إقراراً للعدل والقسط، وقد خلق الله} هؤلاء المجاهدين المضحّين للمجتمع رحمة ورأفة إلهيّة لإصلاحه: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ)[319].
وعلى هذا الأساس قد أرسل الله تعالى الأنبياء لإصلاح جميع شؤون الناس ومجالات حياتهم، وهذا الإصلاح لا يتحقّق من دون الجهاد وقتال الأشرار، ولا طريق لنا لإنهاء هذا الصراع إلّا بالجهاد في سبيل الله الذي دعت إليه جميع الأديان السماويّة.
والإمام سيّد الشهداء× إنّما خرج ليسير بسيرة جدّه[320]، وسيرة رسول الله هي تلك السيرة التي أوضحها الله في القرآن الكريم[321]، إذن فالإمام الحسين× ثار ليقيم ديناً هو عين السياسة، وسياسة هي عين الدين، وهذا الأمر يحتاج إلى السيف والتضحية، وهذه رسالة على عاتق الأمّة الإسلامية، فلا بدّ أن يكون لديها دائماً ثورة وإصلاح على جميع الأصعدة.
وسيّد الشهداء× قام في ظروف معيّنة لإحياء دين يمتلك هذه الأوصاف والخصوصيات، وقد لبَّتْ دعوتُه جماعة ولم تلبّها جماعة أخرى بسبب التضليل الإعلامي والتربوي السيّء لبني أُميّة؛ لأنّ بني أُميّة فصلوا الإسلام عن السياسة، وفسّروا جانبه العبادي بما يتناسب مع ميولهم وأهوائهم، وقد قدّموا للناس ديناً ممسوخاً باسم الإسلام، ولذا قال الإمام الحسين×: «إنّ الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درَّت معائشهم، فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديّانون»[322]، وكما قال القرآن الكريم: (النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ)[323] فالنار هي التي تتولّى أمر هؤلاء، وأنّها لمحيطة بهم، فهم يحترقون ولكن بما أنّهم في سكرة فلا يشعرون بالعذاب.
فكرة فصل الدين عن السياسة الباطلة
إنَّ أمير المؤمنين× كان يؤكّد وجود جماعة يعتقدون بأنّ الدين يتنافى مع الحكم والسياسة فاعتزلوا السياسية والحكم، وأمّا المكرة من السياسيين الذين تسلموا السلطة فيرون الهدنة من طرف واحد، حيث تلاعبوا بالدين وفسّروه ونشروه بما يخدم مصالحهم، ولربما أصبح من وجهة نظر إنسان بسيط عاجز فكريّاً ومتحجّر أنّ الدين لا يمتّ للسياسة بصلة، إلّا أنّ الإنسان المادّي الذي هو كالدنيا «محتاله مي نشيند ومكاره مي رود»[324] لا يعتقد بهذا أبداً، ويستغلّ الدين لمصالحه، وإذا تطّلب الأمر يستغلّ رجال الدين أيضاً، وهذا ما صنعه الأُمويّون حينما استغلّوا الفتوى العامّة لشريح القاضي ومضمونها: «إنّ كلّ من خرج على خليفة رسول الله’ وخرق أمن المجتمع واستقراره فقتاله واجب ودمه مهدور» لصالحهم واعتبروها حجّة وذريعة لوقوف الناس بوجه الإمام الحسين×، وسكت شريح القاضي طلباً للعافية[325] بالتالي استطاع الأُمويون إجبار أهل الكوفة على التوجّه إلى كربلاء لقتل الإمام الحسين× لينالوا بذلك الجنّة. فإنّ الفترة ما بين شهادة مسلم بن عقيل× ووصول الإمام الحسين× إلى كربلاء كانت أقلّ من ثلاثين يوماً، وخلال هذه المدّة القصيرة لا يمكن تجهيز جيش من الشام إلى كربلاء. وهذا الجيش المكوّن من ثلاثين ألف رجل فقد حضروا إلى كربلاء من الكوفة وأطرافها بأمر سياسي من جانب وبمؤامرات الأُمويين[326] وخدعهم من جانب آخر، إذن السياسية المقيتة لا تترك الدين ولا تستغني عنه، بالرغم من أنّ بعض المتديّنين قد تركوا السياسة، وبطبيعة الحال فإنّ معالجة هذا الأمر تحتاج إلى دراسة عميقة.
وكانت هناك في عصر أمير المؤمنين× فرقة ترى أنّ الدين لا دخل له بالسياسة، ولكنّ الفرقة الأخرى تدخّلت بالسياسة، وجعلوا الدين أسيراً بيد السياسة، ولذا قال أمير المؤمنين× في عهده إلى مالك الأشتر: «إنّ هذا الدين قد كان أسيراً في أيدي الأشرار، يُعمل فيه بالهوى وتُطلب به الدنيا»[327] ومعنى هذا الكلام أنّ الحكومات التي سبقت حكومتي كانت تُقيم الصلاة والصوم والحجّ وغيرها من العبادات، ولكنّ أساس الدين فيها أسير بيد الأشرار، ثمّ قال: «لُبس الإسلام لبس الفرو مقلوباً»[328] فالإمام أمير المؤمنين× في مثل هذه الأجواء والأوضاع الوخيمة نهض بالأمر، قائلاً: «اللهمّ، إنّك تعلم أنّه لم يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنردّ المعالم من دينك، ونُظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتُقام المعطّلة من حدودك»[329] وهذا يعني أنّي قمت بالأمر لأرُدّ معالم الدين إلى مكانها الأصلي، وأقيم ما عطّل من الحدود، وأرفع العلم شامخاً بعدما كان منكوساً؛ لأنّ العلم إنّما يصبح علماً إذا كان مرفوعاً شامخاً خفّاقاً.
إنّ المجتمع الإسلامي آنذاك بشهادة الإمام علي× قد لبس الدين مقلوباً، وعطّل الحدود الإلهيّة، وأصبح الدين أسيراً بيد الأشرار حتّى آل الأمر إلى الإمام الحسين×، وهو كأبيه، قد ورد عنه ما يشبه خطبة أبيه الآنفة الذكر، حيث قال: «أللّهُمَّ إِنَّك تَعْلم أَنَّه لَم يَكن ما كان مِنّا تَنافُساً في سُلْطان، ولا التماساً مِن فضُول الْحُطامِ، ولكِن لِنُرِيَ الْمَعالِم مِن دينك، ونُظهِر الإصلاح في بِلادك، ويأمَنَ الْمَظلومون مِن عبادك، ويُعمَل بِفرائضِك وسُنَنِك وأَحكامك»[330].
والغرض أنّ المعصومين^ الشهداء وأصحابهم الخلّص إنّما قاموا واستشهدوا لإعلاء كلمة التوحيد وإحياء دين الله تعالى، ولذا نقول لكلّ واحد من هؤلاء الشهداء: «أشهد أنّك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة»[331]؛ لأنّ الصلاة عمود الدين وما دام العمود قائماً فالخيمة قائمة.
وقد أوصى أمير المؤمنين× قثم بن عباس والي مكّة بقوله: «فأقم للناس الحجّ...»[332] حتّى يعرفوا من يرمونه بالحجارة في (رمي الجمرات) ولماذا، حتّى لا تذهب فائدة الحجّ سدى، وكان ما كتبه: «أقم للناس الحجّ، وذكّرهم بأيّام الله، واجلس لهم العصرين...»[333].
|
حاجي
تو نيستي شتراست از براي آنك بيجاره
خار موخورد وبار مي برد[334]. |
فالفرق بين الإسلام الأمريكي والإسلام العلوي الحسيني هو أنَّ الإسلام الأمريكي يكتفي بالدعاية إلى الإسلام الصوري والظاهري، وأمّا الإسلام الخالص فهو يهتمّ بإقامة مبادئ الدين[335].
الجرعة الثالثة: إجراء العدالة الاجتماعيّة
العدالة هي وضع كلّ شيء في موضعه، والعدالة الاجتماعيّة هي إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه في المجتمع، ويجب بناء المجتمع وتصنيفه على أساس الاستعدادات والطاقات كي يتمكّن المواطنون من معرفة حقوقهم وحقوق الآخرين ويلتزمون بمراعاتها، ويجب على الدولة السعي وبذل الجهود لإقرار العدالة على جميع الأصعدة: الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة، وعلى المستوى الفردي والاجتماعي.
الإمام الحسين× نهض لتحقيق هذا الهدف السامي، فالعدالة هي العنصر المحوري في هذه النهضة الإلهيّة التي أصبح الدين مدين لبركاتها العقديّة والأخلاقيّة والفقهيّة والقانونيّة، ففي ضوء العدالة يتمّ إقرار الأمن والاستقلال والحرّية والاقتصاد والثقافة، ولغياب العدالة الاجتماعيّة انتشرت أنواع الأضرار والصدمات الاجتماعيّة في المجتمعات البشريّة مجتمعاً ودولة.
العدالة التي قام سيّد الشهداء× من أجل تحقيقها تعمّ جميع المجالات التي تحتاجها المجتمعات البشريّة في كلّ عصر، ولا تنحصر بالشؤون المالية أو الرفاهية أو تحقيق الحرّيات السياسيّة، والتطوّرات الاقتصادية.
ومن أهمّ احتياجات المجتمع هي المسائل الاعتقادية والثقافية والأخلاقية، فالاعتقاد الصحيح بالله تعالى وتوحيده الذاتي والصفاتي والأسمائي، والمعرفة السليمة للوحي والنبوّة والإمامة وعصمة الأئمّة^، والاعتقاد الحقّ بالمعاد والحياة بعد الموت، وتحلّي المجتمع بالكرامة الإنسانية التي هي البنية التحتيّة للفضائل والقيم الأخلاقية، كلّ ذلك يدخل في إطار العدالة الاجتماعيّة التي كان ينادي بها سيّد الشهداء×.
إنّ العدالة في الثقافة الإسلامية تساوق العقلانية، فهما مفهومان متّحدان في الواقع الخارجي، فالعادل والعاقل وجهان لعملة واحدة، والعادل هو الذي يضع كلّ شيء في مكانه المحدّد له وكذا العاقل، وهذا ما أجاب به أمير المؤمنين× لمّا طُلب منه أن يصف العاقل حيث ورد: «قيل له: صف لنا العاقل، فقال×: هو الذي يضع الشيء في مواضعه، فقيل: فصف لنا الجاهل، فقال×: قد فعلت»[336] وهذا يعني أنّه إذا عرفنا العاقل فقد عرفنا الجاهل، ويستفاد من كلام أمير المؤمنين× أنّ العادل والعاقل كالظالم والجاهل متّحدان مصداقاً متغايران مفهوماً.
ونهضة الإمام الحسين× هدفها وغايتها إقامة العدل ومحاربة الظلم، وتعليم الأمّة وإنقاذها من الجهالة، وهذا ما ورد في نصّ زيارة الأربعين: «بذل مهجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحَيرة الضلالة»[337]، وهذا يعني أنّ البكاء على مقتل النموذج الكامل للعدالة والعقلانية في الحقيقة هو بكاء على مقتل العدالة والعقلانية ومظلوميّتها، فالبكاء ينوّر القلب إذا كان على أساس عقلي، إلّا أنّ البكاء قد لا يكون قائماً على أساس العقل دائماً، بل قد يكون أحياناً منبعثاً من أساس بايلوجي عاطفي كما هو الحال في الضحك[338].
من أهمّ أهداف نهضة الزعماء الإلهيين بما فيهم الأنبياء والأئمّة المعصومين^ ووكلائهم الخاصّين والعامّين هو تبيين مصادر ومباني العدالة بشكل صحيح، ونهضة الإمام الحسين× جاءت لتحقيق هذا الهدف، وكان الإمام الحسين× يقول: «من كان باذلاً فينا...»[339] وهذه الجملة قد كرّرها عدّة مرّات وفي مواضع مختلفة في المدينة ومكّة وفي طريقه إلى كربلاء وفي كلماته وكتبه، وكان ابن عباس ـ وهو من بني هاشم ـ يُذكّر الإمام الحسين× بتاريخ الكوفة وأهلها وسيرتهم مع ابيه وأخيه، وينصحه بترك التوجّه إلى الكوفة والبقاء في مكّة، أو الذهاب إلى اليمن إذا لم يأمن في مكّة، فإنّ لليمن تاريخاً في الدفاع عن أهل البيت^، أو الصبر أيّاماً قلائل حتّى يُكمل الناس مناسك الحجّ ويتفرّغوا لنصرته، ولكنّ الإمام× لم يقبل بهذا العرض، وأخبره انّ المسألة ليست فتح العراق أو اليمن أو الشام، بل هو عازم على لقاء الله وفتح الوطن الملكوتي، ولو لم ينصره جميع الناس لقام لوحده بهذه النهضة، وأخبره بتمادي بني أُميّة في ظلمهم وجورهم وكفرهم، ثمّ أشار ابن عباس عليه بأن لا يحمل معه النساء والأولاد ويتركهم في يثرب، ولكنّ الإمام الحسين× أراد بحملهم إيصال صوت العدالة إلى أسماع الجميع؛ لتعي الأمّة ذلك جيّداً[340]، وهذا يعني أنَّ الإمام أراد بقطع تلك المسافات التي تبلغ حوالي ألفين كيلو متراً توعية أهل الحجاز والعراق من خلال الكتب والرسائل والخطب العامّة والخاصّة، وتكفّل أهل بيته الذين أُسروا في كربلاء بتوعية المسلمين في المناطق النائية.
إنّ من المصائب الاجتماعيّة المؤسفة التي واجهها الإمام الحسين× والمجتمع الإسلامي آنذاك تزايد الثقافة الجاهليّة الفاسدة المنافية للعدالة، والمنسجمة تماماً مع العصبيّة القوميّة والقيم الجاهليّة المتخلّفة، وكانت تتّسع هذه الثقافة يوماً بعد يوم من خلال وسائل الإعلام بدعم من بني أُميّة، بالإضافة إلى ترويج الشعارات الدالّة على التعصّب القومي، مثل: «اُنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»[341] بفهم خاطئ غير صحيح، وينبغي استبداله بالشعار الإسلامي الحقّ من قبيل: «اُنصر الحقّ أخاك أو غير أخيك».
وقد أصبح في ذلك العصر ارتكاب الذنوب الكبيرة أمراً يسيراً وغير مستقبح، فخليفة المسلمين الذي من وظائفه الأساسيّة رفع راية التوحيد ومحاربة عبادة الأصنام في جميع العالم، كان يبيع الأصنام بكلّ صراحة، ويُصدّرون الأصنام الثمينة إلى البلدان المفتوحة كالهند وغيرها من البلدان[342]، واستُبدلت محاربة بيع الأصنام بتجارة مربحة دون أيّ استنكار أو ردود فعل من قبل المجتمع الإسلامي.
إنّ منشأ الاختلاف في تفسير العدالة وتطبيقاتها يعود للاستناد إلى أسس ومبادئ إقليمية[343]، لا إلى الوحي والفطرة، فالمواد القانونيّة عند الدول العلمانية لا أساس لها ولا مصدر؛ لأنّ هذه المواد مأخوذة من القانون الأساسي وهو غير قائم على أساس ومصدر معتمد، فإنّ مصدره في الدول غير الإسلامية هو الترسّبات الفكريّة والثقافيّة للناس وآراؤهم وأفكارهم، وبحسب تعبيرهم (العقل الطبيعي) الذي حدّدوه بأنفسهم، وجميع هذه الأمور غير مبرهنة ولا قادرة على تحقيق السعادة للإنسان، وقوانين منظّمة الأُمم المتحدة من هذا القبيل!
فهؤلاء لا يرون منهج الأنبياء^ والفطرة مصدراً لاستخراج مباني العدالة وأصولها، ويستبدلونها بالاعتدال، أي: التساوي بين مقدار طلبات المجتمع ومقدار تلبيتها، تطبيقاً لقانون العرض والطلب، فيجب تلبية كلّ ما يطلبه المجتمع مهما كان مقداره ونوعه، وإن كانت تلك الطلبات نابعة من الأهواء والعادات السيّئة، أو قائمة على أسس غير تربوية وشهوات كاذبة.
فالاعتدال المذموم هو الإعجاب بزخارف الدنيا، وحبّ الذهب والفضّة، والرصيد المصرفي، والافتتان بالثروات الحيوانيّة والزراعيّة.
العدالة الممدوحة هي تجاوز كلّ ذلك، وترك المحبّة المفرطة للنساء والأولاد والأهل، والتعلّق القلبي بالإمام علي× وأبنائه المعصومين^، ونهضة سيّد الشهداء× إنّما حصلت لبلوغ الأهداف السامية، والإنسان بسعيه وجهوده يستطيع أن يرتقي إلى الملائكة، كما قال الحكيم السنائي&:
|
تو فرشته شوي ار جهدكني از پي آنك برگ توت است که گشتست به تدریج اطلس[344]. |
فلو فقد الإنسان زينته الأساسية وهي الإيمان والمعرفة الإلهيّة، فلا ريب أنّ قلبه سيتعلّق بحبّ الذهب والفضّة والزرع والأنعام والنساء والبنين: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)[345].
فالإنسان يبدأ مراحل نموّه ورقيّه بالحسّ والشهوة، ثمّ ينمو قليلاً فيبلغ مرحلة الوهم والخيال، ثمّ يرتقي في المرحلة الثالثة إلى العقل والمحبّة، ثمّ يتكامل بالتدريج حتّى يبلغ مراحل العقلانية والكمال ويبلغ مراتب من اللطافة والدقّة والرقي فيجتاز رتبة المحبّة وينال درجة المودّة، ثمّ يترقى بالتدريج حتّى يحظى بمودّة ذوي القربى، ويوفّق لأداء أجر رسالة النبي الأكرم ’: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)[346].
يجب طبقاً لمنهج الأنبياء القائم على محور العقل والعدل أن تخضع رغبات المجتمع لميزان العدل والعقل ووضع كلّ شيء في محلّه بحكمة، وتمييز حاجات المجتمع الحقيقية عن رغباته الطغيانيّة الكاذبة، ولا يحقّ لأيّ أحد أن ينظر إلى رغبات المجتمع بعين طامعة انتفاعيّة ويستغلّها لصالحه، وعلى الجميع لا سيّما القادّة المصلحين هداية المجتمع نحو السعادة الحقيقيّة، وعلى المجتمع الإسلامي تهيئة الأرضيّة المناسبة لإنماء الاستعدادات والطاقات الإنسانيّة العالية.
إنّ المذاهب الماديّة والمنظّمات المرتبطة بها التي تركت الوحي والتعاليم النبويّة جانباً، ليس لديها صلاحية سنّ القوانين إقليمياً ودولياً، وكيف يمكن لجماعة سنّ قوانين عامّة لجميع البشريّة اعتماداً على مبادئ وقيم خاصّة بهم دون الاستناد إلى الفطرة الإلهية المشتركة بين البشريّة، ويتوقّعون ـ بعد هذا ـ تفسير العدالة من قبل الجميع تفسيراً يتناسب مع ما يريدون.
البشريّة ـ حالياً ـ بحاجة إلى قوانين عامّة مأخوذة من أصول وأسس مشتركة، والمصدر الوحيد المشترك هو الفطرة الإلهية المودعة في الإنسان التي بيّنها الوحي، فمثل هذا القانون يمكن تطبيقه بنحو واحد على الجميع، أمّا إذا كان لكلّ دولة مصدر وأصول عرقيّة ومبادئ وقيم خاصّة بها، حينئذ ستفسّر كلّ دولة العدالة طبقاً لأُصولها ومبادئها الخاصّة بها، وتعدّ بعض المجاهدين الفلسطينيين المدافعين عن أرضهم إرهابيين، والصهاينة المعتدين طلّاب عدالة.
العامل الآخر في وجود تفاسير مختلفة للعدالة عند المذاهب الماديّة هو أنّ المجتمعات العلمانيّة تعتقد أنّ الإنسان ليس له حقيقة أخرى وراء كونه حيواناً ناطقاً، إذ يرون اشتراك أمراض الإنسان وعلاجها مع الحيوان، فكلّ ما توصّلوا إليه في إجراء التحاليل على الفئران والأرانب في المختبرات الطبّية يصلح دواء لأمراض الإنسان، والحال أنّ الوحي ومنهج الأنبياء^ يعتقد بمسائل أعمق في كمال الإنسان ونقصانه وصحّته ومرضه، وهذه المسائل ليس لها عين ولا أثر في الثقافة غير الدينيّة، ولا يستطيع الماديّون العثور على علاج تلك الأمراض في مختبراتهم الطبّية أبداً، كمرض النفاق، والطمع بأعراض الناس، والميل إلى اتّباع الأجانب.
القرآن الكريم يرى أنّ النفاق مرض قلبي، إذا لم يعالج المنافق نفسه سيزداد ويصبح مزمناً ويتفاقم عليه المرض كالغدّة السرطانية، وتسيطر على جميع وجوده المعنويّ: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا)[347]، والشره بالنساء من وجهة نظر القرآن الكريم يعدّ مرضاً قلبياً ـ أيضاً ـ وقد أمر الله} المؤمنات ـ تحفّظاً عليهن ـ بالتحدّث بصوت خشن كصوت الرجل، لا بصوت رفيع وجذّاب، وإلّا فيطمع الذي في قلبه مرض: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا)[348].
إنّ القرآن الكريم يعلم بأسباب تشبّث السياسيين بالأجانب، وبما يجري في قلوبهم وعقولهم المريضة التي يزعمون بواسطتها بفشل النظام الإسلامي طبقاً لتصوّرات وتحليلات خاطئة، ويتوقّعون انتصار الكفّار مرّة أخرى، ويسارعون إليهم للأمن من ضررهم، ويتودّدون إليهم كي لا يصيبهم مكروه: (فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ)[349].
وبناء على هذا الأساس: فالماديّون الذين يختزلون حقيقة الإنسان بما يُتوصّل إليه من معلومات في صالة التشريح، لا يستطيعون معرفة هذه الأمراض وعلاجها، والماديّون الذين جعلوا طبيعة الإنسان تحلّ محلّ فطرته، واستبدلوا فطرة الإنسان بطبيعته، واعتقدوا أنّ بداية الإنسان ونهايته هما المهد واللحد، ولم يكن لأصولهم ومبادئهم مصدر معرفي ثابت وشامل، هم أناس خاطئون، ونداؤهم بالعدالة في غير محلّه.
الميل الفطري نحو العدالة الاجتماعيّة
العدالة الاجتماعيّة هي أمر ضروري ومنسجم مع فطرة الإنسان وإبداع نظام الوجود، والعدالة ـ كما تقدّم ـ هي وضع كلّ شيء في محلّه، والله سبحانه عين العدل، وقد خلق عالم الوجود على أحسن وجه تجسّدت فيه عدالته. وإنّ الظواهر الكونية الصغيرة والكبيرة كلّ واحدة منها وضعت في مكانها الخاص من دون زيارة أو نقيصة، بالنحو الذي لا يرى أي نقص في الخلق والمنظومة الكونية. والقرآن الكريم يصرّح بهذه الحقيقة، فلا تجد في خلق الله تعالى أيّ نوع من الخلل، ويدعو الجميع إلى البصيرة وإمعان وتكرار النظر في ظواهر عالم الخلق المنظّمة: (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ)[350].
إنَّ تركيبة أجزاء الإنسان الداخليّة متوازنة مع بنيته الخارجيّة، وإحداهما مكمّلة للأخرى ومنسجمة معها تمام الانسجام: (رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى)[351] فالعدالة الاجتماعيّة ـ بمعنى أن يحتلّ كلّ شيء موضعه ويأخذ كلّ إنسان في المجتمع مكانه المناسب له ـ لهكذا مخلوق في هكذا نظام رغبة فطريّة وعامّة ومتناسبة مع جميع المخلوقات في عالم الوجود، والظلم والنقص والعلاقة غير المتطابقة كلّها أمور أجنبيّة عن منظومة عالم الوجود والصراط المستقيم لجميع الموجودات. نعم، قد توجد في كلّ مجتمع فئة هاربة عن العدالة ومستغلّة للحرّيات المشروعة، ينبغي مراقبتها والحدّ من وجودها.
بناء على هذا الأساس فبيان الحلال والحرام والحقوق والواجبات الاجتماعيّة، والمنع عن ارتكاب المخالفة أمر في محلّه وهو من العدل، أمّا المنع عن ممارسة الحرّيات المشروعة، وبخس حقوق الناس، فهو ظلم موجب لهدر الطاقات والثروات وانحلال الدول، ويمهّد الأرضيّة المناسبة لمسائل أخرى.
كان أمير المؤمنين× في حكومته الإسلامية يوصي عمّاله بالعدل واجتناب الظلم والصرامة في غير موضعها؛ وذلك لأنّهم إن شدّدوا على الناس وأشاعوا الظلم يكونوا قد مهّدوا الأرضيّة لفرار الناس وتمرّدهم: «استعمل العدل، واحذر العسف والحيف، فإنّ العسف يعود بالجلاء والحيف يدعو إلى السيف»[352].
إنّ يوم القيامة هو اليوم الذي تسود فيه العدالة وتظهر بشكلها الكامل، ويتمّ فيه إنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم، وسيكون أشدّ على الظالم وأصعب من يومه على المظلومين: «يوم المظلوم على الظالم أشدّ من يوم الظالم على المظلوم»[353]، «يوم العدل على الظالم أشدّ من يوم الجور على المظلوم»[354].
يرى أمير المؤمنين× العدل كمال، بأن يُجعل كلّ شيء في محلّه: «العدل وضع الأمور مواضعها»[355] والعدالة الاجتماعيّة هندسة للمجتمع على أساس الاستعدادات والمؤهّلات، كهندسة الأبنية لا سيّما العالية منها التي تقتضي وضع كلّ ركيزة وجدار وباب ونافذة في موضعه. وهندسة المجتمع العادلة ـ لا سيّما المجتمعات الكبيرة ـ تتطلّب تسليم الوظائف والمناصب إلى أهلها، ويجلس كلّ مسؤول في مكانه المناسب له، وكما يقال في المجال الأدبي (لكلّ مقام مقال) و(لكلّ مقال مقام)[356] فهكذا الحال على صعيد المجتمع، فلكلّ منصب رجل يناسبه ولكلّ رجل مقال يناسبه، ولايشعر سكّان العمارة بالأمن والطمأنينة إلّا إن بنيت وفق الأسس والمعايير الهندسيّة والفنيّة، وكذا الشعور بالأمن والرفاه الاجتماعي منوط ببناء المجتمع على ركيزة العدالة وحاكميّة الكفاءة.
ولهذه الضرورة الاجتماعيّة قد أمر الله سبحانه الناس بالعدل والإحسان الذي يحتلّ مرتبة أعلى من العدالة، قال الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)[357]، وكان النبي الأكرم’ هو أول من احترم هذا الأمر وعظّمه، ورأى نفسه مأموراً بتنفيذه حيث قال: (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ)[358]، وقد بلغ إصراره حدّاً حتّى لو لم يجد ناصراً لنهض لامتثال هذا الأمر وإقامة العدل بمفرده، وقد أمره الله أن لا يترك الميدان وإن لم يجد الناصر، مع حثّه المؤمنين على الجهاد: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ)[359]، وهذا يعني وجوب نهضة النبي’ لأجل نجاة المجتمع وإن كان وحيداً، ومهما كلّفه الأمر.
وسيّد الشهداء× وهو من النبي’: «حسين منّي»[360]، كذلك هو مأمور كجدّه’ بإقامة العدل والإصرار والثبات على هذا الطريق بالرغم مِن ترك الجميع نصرته حتّى بإيوائه، ولذا حتّى لو لم يكن لديه ملجأ ولا مأوى فإنّه لن يبايع يزيد: «والله، لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت[والله] يزيد بن معاوية»[361].
مصادر العدالة وأسسها
العدالة من الكلمات اللطيفة المحبوبة عند الناس، والظلم من الكلمات السيّئة والقبيحة عندهم، ولكنّ اختلاف مصادر المعرفة عند العلماء أوجب الاختلاف في فهم هذين المفهومين وتصوّرهما، ولتوضيح ذلك من أجل معرفة العدالة وجميع الأمور القانونية، لا بدّ أن نطوي مراحل ثلاث:
1ـ معرفة المصدر أو المصادر.
2ـ استخراج الأصول والأسس من المصادر.
3ـ إرجاع المواد القانونيّة إلى الأصول والأسس.
على سبيل المثال: يعتمد الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعيّة على معرفة المصادر الفقهيّة وأدلّة الأحكام الفقهيّة كالكتاب والسنّة والعقل أوّلاً، ثمّ العمل على استخراج الأصول والأسس من المصادر الفقهيّة ثانياً، وبعدها يقومون بإرجاع المواد الفقهيّة والمسائل الشرعيّة إلى الأصول والأسس.
القوانين الاعتياديّة لكلّ بلد تسير وفق هذه المراحل، والمواد القانونيّة تستند إلى قانون أساسي، والقانون الأساسي يستند إلى المصادر الخاصّة بذلك البلد، مثلاً: القانون الأساسي لنظام الجمهوريّة الإسلاميّة يستند إلى القرآن الكريم وسنّة النبي’ والأئمّة المعصومين^ والعقل البرهاني.
والعدالة التي تحيطها صبغة حقوقية مأخوذة من أصول مستندة إلى مصادر خاصّة، والسرّ وراء تعدّد وتنوّع تطبيقات العدالة وتفسيراتها يكمن في اختلاف الأسس ولا سيّما في مصادرها.
لقد بني الإسلام وجميع الأديان التي بقيت مصونة من التحريف العدالة على أساس الفطرة الإنسانيّة، وهي أكثر الوجوه المشتركة بين جميع البشر أصالة، والمنسجمة مع تعاليم القرآن الكريم وسنّة المعصومين^، فالأصول والمبادئ المأخوذة من الفطرة كليّة ودائميّة غير محدودة بزمان ولا مكان، وبالنتيجة لا تختصّ العدالة الإسلامية بمنطقة ولا مقطع ولا جماعة خاصّة.
توضيح ذلك: الإنسان يمتلك جسماً وروحاً، وهويّته بروحه التي هي أصله وحقيقته، وأمّا الجسم فهو ظلّ الروح وفرعها، والروح موجود مجرّد وأبدي، وهي مسافر أقبل من بعيد وسيذهب إلى مكان بعيد، حينما ينام الإنسان ويرى رؤى صادقة ـ وكلّنا قد جرّب هذه الحالةـ فالجسم راقد على الفراش، ولكنّ الروح لا تنام أبداً، وهي دائماً في رحلة وسفر. فحقيقة الإنسان وهويّته هي تلك الروح التي هي حياة البدن.
إنّ الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان من جسم وروح (الطبيعة والفطرة) بتركيب متوازن ومنسجم مع بعضه البعض: (الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ)[362] وخلق مسالكه الإدراكية والإرادية كاملة وسالمة ومتعادلة، فجعله مستوي الخلقة (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا)[363]، وإذا بقيت فطرة الإنسان على حالها دون نقص أو عيب وازدهرت، يمكنها ـ عندئذٍ ـ تمييز الفجور والتقوى والكمال والنقص بشكل جيّد (فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)[364]. والمصدر الأساسي لمعرفة روح الإنسان وفطرته والاطّلاع على بدايته ونهايته هو الوحي وكلام خالق الإنسان.
إنّ الأنبياء^ هم أأمن أشخاص تلقّوا الوحي من خالق الإنسان وبلّغوه كما هو للبشريّة، فالرسل وأوصياؤهم يهدون الإنسان من جهة: بالعرفان والعبادة للغوص في بحر معرفة النفس المليء بالجواهر والدرر، ويأخذون بيده إلى أعماق وكنه باطنه، ويوصلونه إلى مشاهدة فطرته الإلهيّة، ومن جهة أخرى: يأخذون بالحكمة والموعظة بيد أكرم المخلوقات ويركبونه جناح الفكر، ويحلّقون به في سماء معرفة الإنسان الكامل؛ ليعرف المظهر الأتمّ والأكمل لأسماء الله وصفاته، ويدرك بحكمة حقيقة الإنسان الإلهيّة ما أمكنه.
ولو لا الأنبياء^ وأخبارهم الصادقة التامّة حول بداية الإنسان لما علم أحد شيئاً عن بداية الإنسان والعوالم التي لا تحصى قبل الحياة الدنيا، ولما علم الإنسان بالعوالم التي تأتي بعد هذه الحياة، قال الله تعالى: ( عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)[365]، وإنّ نطاق معلومات الإنسان حول نفسه والآخرين من دون الوحي محدود جدّاً، ولا تعدو دائرة حياة الإنسان الدنيويّة التي تبدأ بالنطفة وتنتهي بالقبر.
فهذه المعلومات القليلة الناقصة: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا)[366]لا تصلح أن تكون مصدراً جيّداً للأصول والأسس التي تُشيّد قصر العدالة الشامخ، بالرغم من أنّ الإنسان يحسبها كثيرة، والفطرة الملكوتيّة هي المصدر الوحيد والبنية التحتيّة الوحيدة لهذا البناء الرفيع ولا طريق يوصلنا إليها إلّا الوحي والأنبياء.
ولو انضمّت إرشادات الأنبياء والوحي الإلهي إلى الفطرة الإلهيّة، وأصبحا معاً مصدراً لمبادئ العدالة وأصولها، واستُنبط منها المواد القانونيّة، ثمّ طُبّقت، حينئذ ستصبح العدالة شجرة ضخمة ذات جذور راسخة وأغصان متشابكة وأوراق كثيرة، تُعطي دائماً ثمار الحرّية والاستقلال والرشد العلمي والتربية الأخلاقيّة والرفاه الاقتصادي: (كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا)[367]؛ لأنّ جذور هذه الشجرة الطيّبة نابتة في أعماق نظام الخَلق العادل، وتتناغم أغصانها وأوراقها مع خلقة الإنسان المنظّمة، فالله العادل قد خلق كلّ شيء على أساس العدل: «بالعدل قامت السماوات والأرض»[368].
ولو حلّت طبيعة الإنسان مكان فطرته الإلهيّة وأصبحت العادات والتقاليد المعروفة بين الناس هي المصدر لاستنباط مبادئ العدالة وأصولها ـ كما يقول الماديّون ـ لأصبحت العدالة كشجرة لا جذور لها ولا أغصان ولا أوراق، ولا أنّها لا تأتي بثمر طيّب وحسب وإنّما تصبح مصدراً لتبرير الكثير من المظالم والاعتداءات: (كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ)[369]؛ لأنّ هذه الشجرة اجتُثّت من فوق الأرض وليس لها جذور في نظام الخَلق، ولا تتناغم أغصانها وأوراقها مع فطرة الإنسان ونظام خلقه.
والنتيجة: إنّ مصادر العدالة ومبادئها وحدودها، والحرّية وحقوق البشر وما شابهها، ليس لأحد إدراكها وتحديدها إلّا خالق الإنسان بعلمه اللا متناهي وقدرته الأزلية، والبشريّة من دون الوحي عاجزة عن معرفة البُنى التحتيّة لهذه المفاهيم المعياريّة وجاهلة بحدودها[370]، ومغلوب على أمرها في وضع القوانين الصحيحة حتّى في المسائل الجزئيّة جدّاً كالإرث.
فالإرث فريضة ـ كما أقرّه القرآن الكريم ـ من الله العليم والحكيم، حيث قال : (لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)[371] وهذا يعني أنّكم لا تعلمون أيّهم يُنفق أموالكم إنفاقاً صحيحاً أو خاطئاً كي يكون تعيين سهام الإرث على عهدتكم، إذن إيّاكم وتغيير حكم الله}، والتعدّي بالزيادة أو النقيصة عن الفرض الذي عيّنه الله تعالى لهم وحرمان أحدهم من الإرث.
نعم، الإنسان على ضوء هداية الأنبياء^ وبالعرفان والحكمة، يستطيع معرفة كلّ ما في العالم إلّا معرفة كُنه الله سبحانه وتعالى وصفاته الذاتيّة التي لا يمكن لأحد أن يدركها: «لا يُدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن»، والأنبياء وأوصياؤهم قد أرشدوا الإنسان وأخبروه من خلال هذين الطريقين بأنّه موجود خالد، ومحلّ عمله في الأرض ومكانته ورزقه في السماء: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)[372].
والإمام الحسين× دعا من كان معه، ومَن شاركه في ثورته الدمويّة الموطّنين أنفسهم على لقاء الله، والذين بذلوا أنفسهم لله في تلك البقعة المباركة: «مَن كان باذلاً فينا مهجته، وموطّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا»[373]؛ لأنّ غاية الإمام× من نهضته كانت إعلام غالبية الناس بعزمه على الرحيل وإخبارهم بموطن لقاء الله، لا السيطرة على أرض العراق والشام.
ويا للأسف، إنّ الكثير من الناس قد غفلوا عن أصلهم ونسبهم وموطنهم الأصلي، ونسوا من أين أتوا وإلى أين هم ذاهبون، توهّموا أنّهم بالموت يتلاشون، والحال أنّ الإنسان بالموت يخرج من القشر ويبدأ حياته الحقيقيّة: (وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)[374] «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»[375].
وما أحلى وأجمل كلام الشيخ البهائي& في بيان معنى «حبّ الوطن من الإيمان»[376]:
|
اين
وطن مصر وعراق وشام نيست اين وطن شهريست كان را نام نيست[377]. |
ويستفاد من كلام الحكيم الإلهي شيخ الإشراق الذي صرّح في بيان معنى «حبّ الوطن من الإيمان»[378]: أنّ الإنسان لا بدّ أن يعرف من أين جاء وإلى أين يذهب، وأين هو حاليّاً، ولا ينبغي له ـ أبداً ـ أن يتّخذ وسط الطريق ـ أي الدنيا ـ وطناً[379]؛ لأنّ الإنسان من الله وإليه: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)[380] وحرف الياء في قوله تعالى: (وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي)[381] يُحدّد وطن الإنسان، وحرف (الياء) يبيّن أصل ونسب الإنسان وبدايته ولقاءه الملكوتي لله} وجواره الجبروتي له، وهذا أعظم شرف للإنسان وخير مستمسك على كرامته.
الإنسان بلحاظ تجلّيه نفخة إلهيّة من روح الله، وعلى حدّ تعبير أمير المؤمنين×: «الحمد لله المتجلّي لخلقه بخلقه»[382] وما أعظمه من ظلم وأشدّه من جفاء أن يغفل الإنسان عن هذا النسب، بل يجهله ويتوهّم أنّ الدنيا هي معبوده وموطنه، مع أنّها مجرّد محلّ عمل وعبادة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ)[383].
عاش الحكيم السنائي& قبل مولوي والعطار، ونجد الكثير من كلمات وأشعار هؤلاء الأدباء كانت مسبوقة بتدريس وتعليم وتبيين ذلك الحكيم الإلهي الذي يقول: إنّ جمال وزينة الكعبة بالياء في قوله (بَيْتِيَ): في الآية: (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ... )[384] وبيت الله في غنى عن تزيينه بقطعة قماش مزخرفة:
|
كعبه
را جامه كردن، از هوس است ياء
بيتي جمال كعبه، بس است[385]. |
إنّ جمال وزينة أنفسنا ـ أيضاً ـ تكمن في ياء (رُوحِي)[386] لا بالزينة والحلي التي تزيّن الجسم، والأرض بسعتها وما فيها من نعم مزرعتنا: «الدنيا مزرعة الآخرة»[387] وأنّ مستقرّنا بمجاورة الحقّ ولقائه. فلا بدّ من النجاة من مزرعة الأرض والانتقال منها إلى المقرّ، وإلّا سنُقيّد بالسلاسل والحديد والأغلال ونُؤخذ إلى الجحيم ـ لا سامح الله ـ : (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوه ُ)[388] إذن فلا يتعلّق قلبك بهذه المزرعة وما فيها؛ لأنّ روحك طائر الروضة الملكوتيّة التي بالموت ستحلّق حول العرش.
|
مرغ دلم طايرى است، قدسى عرش آشيان از قفس تن ملول، سير
شده از جهان از در اين خاكدان،
چون بپرد مرغ ما باز نشیمن کند، بر سر
آن آشيان چون بپرد زین جهان،
سدره بود جای او تکیه گه بازِ ما،
کنگره عرش دان سایه دولت فتد، بر سر
عالم بسی گر بزند مرغ ما، بال
وپری در جهان در دو جهانش مکان،
نیست به جز فوق چرخ کان وی آن معدن است،
جای وی از لامكان عالم علوى بود جلوه
گه مرغ ما آب خور او بود، گلشن
باغ جنان چون دم وحدت زنی،
حافظ شوريده حال! خامهء توحيد كش، بر ورق انس وجان[389]. |
نفترض تارة أنّ العدالة الاجتماعيّة حدودها المجتمع الإسلامي، وأخرى نفترض أنّ دائرتها أوسع، أي: تشمل كلّ المجتمعات الموحِّدة كالمجتمعات المسلمة والمسيحيّة واليهوديّة، حيث إنّ المعيار العام فيها هو الاعتقاد بالله والقيامة والنبوّة العامّة، وإن اختلفت الآراء في النبوّة الخاصّة، وأمّا الدائرة الثالثة للعدالة الاجتماعيّة فهي تشمل كلّ المجتمعات البشريّة سواء كانت موحِّدة أو ملحدة، والمحور في هذه الدائرة هو علاقة الإنسان بأبناء نوعه بغضّ النظر عن عقيدتهم ومذهبهم.
الإسلام هو دين شامل لكلّ العالم، فهو دين عالميّ خالد، ولديه خطاب شامل لجميع البشريّة بمجتمعاتها الثلاثة المتقدّمة: المسلمة والموحِّدة والملحدة. وقد بيّن القرآن الكريم طريقة التعامل فيما بين المجتمعات الثلاثة، فقد بيّن للمسلمين طريقة التعامل فيما بينهم في دائرة المجتمع الإسلامي، وبيّن للمسلمين طريقة التعامل مع الأقلّيّات الدينيّة أو الأكثريّة الدينيّة في المجتمع الموحِّد، كما بيّن الدائرة المسموح بها في التعامل مع المنكرين لله والوثنيين في دائرة المجتمع الملحد.
فالقرآن الكريم بعد إعطائه صفة الرسميّة للعدالة الاجتماعيّة في كلّ المجتمعات المذكورة، يُقرّر للمسلمين طريقة التعامل في دائرة المجتمع الإسلامي، ويقول: ينبغي أن تكون طريقة التعامل على أساس الأخوّة الإيمانيّة: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ)[390] وأمّا بالنسبة إلى المجتمع الموحِّد فإنّه يأمر المسلمين برعاية الحقوق والتكاليف المشتركة، حيث يقول: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ...)[391] وأمّا بالنسبة إلى المجتمع البشري فيأمر المؤمنين بتوثيق علاقاتهم مع كلّ المجتمع الإنساني على أساس العدل والسلم ما دام أولئك ملتزمين بالتعايش السلمي، ولم يكونوا بصدد إيذاء وقتل المسلمين ونفي قادتهم: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ...)[392].
إنّ قادتنا يتّبعون أمر الله تعالى في مراعاة العدالة في المجتمعات المذكورة، وهم ينادون بالعدالة دائماً، ويأمرون المؤمنين بضرورة الالتزام بها ولا سيّما المسؤولين وحكّام الدولة.
إنّ أمير المؤمنين× أمر مالك الأشتر ـ والي مصر ـ بمراعاة حقوق جميع أهل مصر بما فيهم المسلم والكافر كي لا يتوّهم أنّ مَن يتمتّع بحقّ المواطنة هم مسلمو مصر وحدهم، وأمّا الآخَرون فهم أجانب وليس على حكّام الدولة أيّ مسؤوليّة تجاه تأمين حقوقهم الاجتماعيّة، وأوصاه بأن يرحم الرعيّة ويعطف عليهم، وأن لا يحرمهم من عطفه ومحبّته، ولا يكون تعامله معهم كالسبع الضاري يرى طعامهم مغنماً؛ لأنّ الناس إمّا أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، حيث كتب له: «واشعر قلبك الرحمة للرعيّة والمحبّة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صنفان: إمّا أخ لك في الدين، وإمّا نظير لك في الخلق»[393].
النموذج الآخر للحفاظ على حدود العدالة وتطبيقها على الجميع على حدّ سواء، هو نهضة سيّد الشهداء×، فإنّ رسالته في المجالات المذكورة هي رسالة الإسلام، فإنّه قد فسّر بنهضته العدالة على جميع الأصعدة والمجالات، حيث قال: إنّ الحرّية هي رسالة الإسلام للمجتمع البشري ككلّ حتّى بالنسبة لمن لا يعتقد بالمبدأ والمعاد، فالحرّية غير ممكنة التحقّق دون العدالة.
فالإنسان العادل هو من تحرّر واقعاً من القيود الخارجيّة والداخليّة، أي: الذي لا يخضع لسلطان الآخرين (الحرّية الخارجية) ولا يجرّ الآخرين ليجعلهم تحت سلطته (الحرّية الداخليّة) وهذا هو معنى العدالة، فهي تجنّب الخضوع للسلطة الظالمة وترك ظلم الآخرين، ويشهد على ذلك العقل السليم المتحرّر من أسر الهوى وحبال الدنيا: «شهد على ذلك العقل إذ خرج من أسر الهوى وسلم من علائق الدنيا»[394].
إنّ الكلام المعروف لسيّد الشهداء×: «إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم»[395] ناظر إلى الحكمة النورانيّة الآنفة الذكر التي صدرت من أبيه أمير المؤمنين×: «شهد على ذلك العقل...» إنّ أصحاب النبي الأكرم’ قد تعلّموا في ضوء تعاليم القرآن الكريم وإرشادات النبي الأكرم’ وجوب تطبيق العدالة في المجتمعات الثلاثة:
1ـ المجتمع الإسلامي، حيث يجب أن يكون المسلمون رحماء فيما بينهم (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ... رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)[396]، وكرماء فيما بينهم ينفقون أموالهم عند السرّاء والضرّاء ولا يبخلون عن بذل المال، ومتسامحين فيما بينهم يتجاوزون عن أخطاء الغير، وحلماء وكاظمين للغيظ عند الغضب، بل يحسنون إلى المسلمين (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)[397].
2ـ المجتمع الديني الموحِّد، حيث ينبغي التعاون مع أتباع الديانات السماويّة الأخرى، واحترامهم والحديث معهم بالموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن كي يمهّدوا الأرضية المناسبة لهدايتهم (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[398].
3ـ المجتمع البشري، حيث يجب الحفاظ على التعايش السلمي مع الكفّار، فعلى المسلمين أن يحملوا بيدهم القرآن الكريم الذي هو رمز التعقّل والحكمة لهداية الناس، ويحملون السيف بيدهم الأخرى الذي هو مظهر القدرة والصلابة لمواجهة الجبابرة والمتسلّطين، ويجب علي المسلمين الحفاظ على مصباح الهداية كي لا يسعى الأجانب لإطفائه (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ)[399].
|
به یک دست گوهر به یک
دست تیغ به گوهر جهان را
بیاراسته به تیغ از جهان داد ودین خواسته[400]. |
مراتب العدالة الاجتماعيّة
القرآن الكريم قد وصف العدالة وأصحابها بأوصاف مختلفة، فتارة يأمر بالعدل بصيغة الأمر، ويعلّل ذلك بأنّ العدل أقرب إلى التقوى: (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)[401] وأخرى يأمر بالعدل بمادّة الأمر ويقول: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)[402] ومَن أطاع أوامر الله تعالى في هذه المرحلة فقد امتثل وظيفته الأولى، ولم تصبح العدالة مَلكة له حتّى الآن، فبمجرّد هذا الامتثال لا يعدّ الإنسان قائماً بالقسط والعدل، ولا تنغرس العدالة بمجرّد ذلك في نفس الإنسان بحيث تصبح من صفاته ومقوّماته.
إنّ نشر العدالة وبلوغ المجتمع مرتبة القيام بالقسط واحدة من الأهداف السامية لبعثة الأنبياء في الأبعاد الاجتماعيّة: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا... لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)[403] فالله يرسل الأنبياء والرسل ليتمّ نشر العدالة حتّى يصبح جميع الناس قائمين بالقسط.
و المرتبة الراقية من العدالة هدف أسمى، يحتاج تحقيقها إلى مسؤوليّات أكبر على مستويات راقية، وهي أن يكون الإنسان قوّاماً بالقسط (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ)[404] وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)[405]، والمخاطب في هذه المرتبة إنّما هو فئة خاصّة من المؤمنين، فهذا الخطاب غير موجّه إلى الناس وعامّة المؤمنين؛ لأنّه غير مقدور لهم.
إنّ لفظة (علّام) صيغة مبالغة تطلق على العالم غزير العلم وذي جدّ واجتهاد واسع، وكذا لفظة (قوّام) فالقوّام بالقسط هو العادل الذي يقوم بالقسط ويتحوّل القيام بالقسط عنده إلى مَلكة، ثمّ تشتدّ مَلكة القيام بالقسط عنده حتّى تصبح (فصلاً مقوّماً) بنحو لا يفارق جوهره وحقيقته.
فالقوّام بالقسط هو من يذوق طعم العدالة ويسـتأنس بكونها متاعه في سلوك الطريق، ويلتذّ بشهود المقصد، ويحظى بلذّة شهود المقصود، فهكذا إنسان كامل جامع لا تؤثّر عليه الحوادث ولا تزعزعه في جهاده الأصغر والأكبر: «لا تحرّكه العواصف»[406] ولديه القدرة على الإتيان بمهامّ عظيمة على حدّ المهامّ التي قام بها الإمام الحسين×، وإن كانت المهمّة التي أنجزها الإمام الحسين× لا نظير لها ولا يسبقها شيء ولا يلحقها شيء.
إنّ الشخصيّات العظيمة كيحيى الشهيد والإمام الحسين×، مستعدّة لبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على المجتمع البشري، ولو كلّفهم ذلك أن تُهدى رؤوسهم إلى الطغاة والأرجاس من الناس، فهم يتمتّعون بروحيّة عالية وقوّة إلهيّة فريدة من نوعها، بها استطاعوا الخروج من مسؤوليّة الوفاء بعهد العبوديّة لله على أحسن وجه[407].
هذه شخصيّات قد اجتازت مرحلة العدالة وبلغت مرحلة (قوّامين لله) كما في قوله تعالى: (قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)[408]؛ لأنّهم أطاعوا الأمر الإلهي المتمثّل في قوله تعالى: (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)[409] وامتثلوا قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)[410]، وقد وصلوا إلى مرحلة (قوّامين بالقسط): (قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ)[411]. فهذه الثلّة الطاهرة قد استعدّت بكلّ رغبة وميل لمواجهة الظالمين والمستكبرين الذين يقضون على الإسلام والدين إن تمكّنوا من السلطة والحكم كما قال الإمام الحسين×: «وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليت الأمّة براع مثل يزيد»[412]؛ لأنّ هذه الثلّة الطاهرة ترى أنّها الأجدر بالحكم والتغيير: «أنا أحقّ مَن غيَّر»[413].
العدالة في الأديان الإلهيّة تتميّز بخصلتين مهمّتين: امتلاك مصدر علمي، وامتلاك دعامة تنفيذيّة، فإنّ بداية العدالة الإسلامية وتنفيذها مسبوقة، وملحوقة بضمان تطبيقها، فبدايتها مستندة إلى المبدأ ومنوطة بالاعتقاد بالله تعالى، وتنفيذها يظهر في المعاد وملحوق بالإيمان بحكمة العدل الإلهي والأجر والثواب.
بناء على هذا فالجهاد والشهادة بإخلاص، والتضحية بالنفس، والإيثار بالمال لتحقيق العدالة، إنّما يكون مقبولاً مع الإيمان بهذه العقيدة والمبادئ، وهذا ما كان يتمتّع به الإمام الحسين× وأصحابه، أمّا تصوّر صدور هذه التضحيات من شخصيّات خالية من الإيمان بهذه الاعتقادات، وترى الموت انعداماً أبدياً، ولا تتمتّع بأخلاق وقيم دينيّة، فهو ضرب من الوهم والخيال، ففي هذا النوع من المجتمعات لا وجود لضمان تطبيق العدالة؛ لأنّ المجتمعات الملحدة لا تعتقد بالله ولا بالمعاد، وتزعم أن لا حياة للإنسان إلّا في الدنيا، ويهلكهم الدهر ويعدمهم إلى الأبد (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ)[414].
ويرى بعضهم أنّ الاعتقاد بالله تعالى من الأساطير (إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)[415] ويعتقدون بأنّ الخوف من عدل المحكمة الإلهيّة والبرزخ عبارة عن أوهام كمن يخاف من الفأر والحشرات، واختاروا الأهواء والشهوات خُلقاً لهم، واتخذوا الهوى إلهاً من دون الله، ورجّحوا التغطرس على التعبّد، ويرون القيم الأخلاقيّة دون شأنهم.
وكأنّ احترام القانون والحذر من هتك الحُرمات غير نافع لا سيّما عند المتكبّرين الذين يرون أنفسهم فوق القانون، وما دام زمام السجن والعقوبات بأيديهم إذن فما هو الوجه الذي يفرض على هؤلاء الالتزام بالعدالة؟ وما هي الضمانة للالتزام بالقانون من قبل جماعة ترى أنّ الحياة تتلخّص في العيش عدّة سنين في الدنيا، ثمّ تنعدم بالموت وينتهي الأمر. هذه الطائفة لا تختلف عن فرعون الذي رفع شعاره (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى)[416].
فما الوجه الذي يُلزمهم بمراعاة العدالة والالتزام بها، وما الأمر الذي يفرض عليهم التخلّي عن الثروات الطائلة التي باستطاعتهم ابتزازها من الشعوب المظلومة؟ أليست نتيجة هذا النوع من التفكير والأخلاق والسجايا إلّا زيادة التمسّك بالسلطة الاستكبارية وتقويتها يوماً بعد يوم، واستضعاف الأمم والشعوب واستعبادها باسم العدالة والحرّية والديمقراطيّة وحقوق الإنسان كما نراه اليوم في العالم، والتاريخ يشهد على هذا الأمر؟!
وعليه فالخلاف بين الأنبياء^ وأعدائهم ليس اختلافاً على مستوى العلم والدين فحسب كي يمكن حلّه بالحوار المنطقي، فإنّ الخلاف بينهما لو لم يتجاوز هذا المستوى لأمكن حلّه بقبول الدين للمسائل العلميّة وقبول العلم والعقل للمسائل الدينيّة، ويتمّ التوفيق بينهما، إلّا أنّ اختلاف الأنبياء مع المتسلّطين تجاوز مرحلة الحوار والحديث والتصالح؛ لأنّ أفكار الفريقين تجرّهم إلى حرب بكلّ ما للكلمة من معنى، فالأنبياء يهتفون بشعار: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى)[417] و(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)[418] والطرف الآخر يرفع راية(وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى)[419] ويطبّقها قولاً وعملاً.
والأنبياء^ على أساس الحقّ يرون أعداءهم حيوانات، بل أضلّ من الحيوانات (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ)[420] ذلك أنّهم قد فقدوا أبصارهم وأسماعهم وشعورهم وعقولهم: (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ)[421] وأمّا الأعداء فينظرون إلى أفكار الأنبياء^ كأساطير خالية قد انتهى أمدها (إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ)[422].
إذن لا يمكن دعوة هذين الفريقين إلى الحوار والاتفاق والتعاون المشترك، ولا يمكن إقرار الصلح بينهما، فكما لم يمكن إقرار الصلح والسلم بين موسى وفرعون، فموسى× كان يدعو إلى تهذيب النفوس وتنمية عقلانيّة المجتمع وكان شعاره: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا)[423]. وأمّا فرعون فكان يدعو إلى السلطة والقوّة وشعاره: (وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى)[424].
امتزاج العدالة بالتكليف والحقّ
العدالة ميزان ذو كفّتين؛ كفّة التكليف وكفّة الحقّ، فكفّة التكليف: هي عبارة عن التكاليف التي جعلها الله سبحانه على عاتق الإنسان تجاه المجتمع أو الأفراد كالأقرباء والجيران والزوجة والأبناء، وأمّا كفّة الحقّ: فهي عبارة عن الحقوق التي أقرّها الله والمجتمع واعترفا بها للإنسان رسميّاً وأعطوه حقّ الدفاع عنها.
إنّ من المؤشّرات القطعيّة للعدالة هي: إباء الذلّ، وترك الدخول تحت ولاية الجور، والسرّ في حرّية واستقلاليّة الأفراد والشعوب المطالبة بالعدالة ـ دائماً ـ هو عدم الانسجام والتنافر المتأصّل بين الظلم وطلب العدالة، فأهل العدل يؤدّون حقوق الآخرين وينالون حقوقهم، فلا يؤدّون الحقوق من طرف واحد، وأمير المؤمنين× يعتبر أداء الحقوق من طرف واحد نوع من الذلّ والعبوديّة للآخرين: «من قضى حقّ مَن لا يُقضي حقّه فقد عبده»[425]، وهذا الكلام القيّم ينطبق على الأفراد والشعوب التي تتولّى السلطة والقوّة وتتقبّل الظلم، وأمّا في كفّة الحقّ فإن كان الأفراد والشعوب من أهل الإحسان والعفو والصفح، بحيث يتنازلون عن حقوقهم بكرم وشهامة، فإنّ هذا التنازل الكريم والقويّ لا ينافي العدالة فحسب، بل يدخل تحت مفهوم الإحسان الذي هو مفهوم أرقى من العدالة، وكما ذكرنا أنّ الله ـ سبحانه ـ كما أمر بالعدالة أوصى بالإحسان أيضاً: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ)[426] ولعلّ الترتيب في الآية حيث ذكر العدل ثمّ الإحسان يدلّ على أنّ الإحسان مرتبة أعلى من العدل.
والهدف من نهضة سيّد الشهداء× إطلاع الناس والشعوب على حقوقهم المشروعة لأخذها، ومعرفة حقوق الآخرين كي يتمكّنوا من أدائها، وأعلى من ذلك: أن يصبح الناس والشعوب من أهل الإحسان والعفو عن الآخرين.
إنّ المجتمع الإسلامي في عصر النبي الأكرم| هو نموذج من المجتمع العادل، فأصحاب رسول الله| على ضوء هدايته وإرشاداته وفي ظلّ التعاليم القرآنية التي تحييهم، كانوا يعترفون بحقوق الآخرين المشروعة ولا يبخسونها، وهم عارفون بحقوقهم ويأخذونها بالقول والعمل، ولا يسمحون لأحد أن يضيّع حقوق الآخَرين.
وقد أثنى أمير المؤمنين× على الأصحاب، وذكر أنّهم قد ربّوا الإسلام بأيديهم وألسنتهم كما يُربّى الطفل في الحجر، حيث قال: «هم ـ والله ـ ربّوا الإسلام كما يُربّى الفلو مع غنائهم، بأيديهم السباط وألسنتهم السلاط»[427].
(ربّو الإسلام) أي: نمّوا الإسلام، ونشروا القيم الإسلامية في المجتمع، وأهمّها نشر العدل، (بأيديهم السباط) أي: أنّهم أسخياء، يؤثرون بأموالهم ويسدّون بها احتياجات الإسلام والمسلمين. ويحتمل أن يكون المراد بها التضحية بالنفس، والمعنى: أنّهم عرّضوا أرواحهم للخطر، وحملوا السيف بأيديهم؛ ليسلبوا الأمن من أعدائهم، ويضحّون بأنفسهم لمنع أيّ نوع من الاعتداء.
(ألسنتهم السلاط) أي: كلامهم مبرهَن ومتقَن وسديد (وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا)[428] فأنصار النبي الأكرم| كانوا فصحاء يجيدون أساليب الكلام وكلامهم نافع، يوضّحونه ببيان رائع وجميل.
إذا أرادت الأمّة الإسلاميّة أن تبقى مقتدرة عالميّاً ويسودها العدل، فيجب عليها الاقتداء بالنبي الأكرم|، وعليها أن تحمل القرآن الكريم بيد وتحمل السلاح باليد الأخرى (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)[429]وإن لم تفعل ذلك فسيسلب الأعداء بهجماتهم الواسعة البشعة قيمها الدينيّة ومبادئها الأصيلة (وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا)[430]، وسيمحون الأُمّة الإسلامية من الوجود بأسرع وقت (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ)[431]؛ لأنّ أئمّة الكفر لا يلتزمون بأيّ عهد وميثاق (فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ)[432].
إنّ القرآن الكريم لم يقل ـ أبداً ـ : قاتلوا أئمّة الكفر لأنّهم كافرون، بل قال: قاتلوا أئمّة الكفر؛ لأنّهم لا أيمان ولا عهد لهم، ولا مجال للحياة السلميّة مع نقض الميثاق وخلف العهد. نعم، ما دام هؤلاء يلتزمون بالعهد ويحترمون الحقوق ولا ينقضون العهود والمواثيق المحلّية والدوليّة فعلى المؤمنين رعاية حقوقهم: (فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ)[433].
إنّ الإنسان مسافر كادح للقاء جلال الله وجماله ( يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ)[434] وخير متاع وزاد وراحلة في هذا السفر هو التقوى، ومن شرب قدحاً من التقوى ارتفع عطشه كمن شرب الماء من حوض الكوثر (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى)[435].
إنّ العدالة أفضل وسيلة لتحصيل التقوى وأقرب شيء إليها (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى)[436] وإذا حصل الإنسان على مَلكة العدالة دخل في قائمة المتّقين، وإذا دخل في قائمة المتّقين نال فرقاناً (إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا)[437] يُميّز به بين الحقّ والباطل، إنّ التقوى في العمل وسيلة لنيل معارف علميّة كثيرة، لا يتيسّر للإنسان سماعها عن أستاذ ولا مطالعتها في كتاب (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ)[438](وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)[439]، وهذا يعني أنّ الله تعالى يُعلِّم الإنسان المتّقي علوماً لم يكن يعرفها من قبل، ولا يمكن أن يعرفها لا بطريق التسبيب ولا بالمباشرة، بل الاطّلاع على تلك العلوم منحصر بالتعليم الغيبي.
وبالعدل يبلغ الإنسان فوائد التقوى الشاملة للمعقول والمنقول والشهود، وبواسطة الإلهام الإلهي يمكنه طيّ الأرض والزمان، والاطّلاع على آفاق الأرض وبقاعها بلا حاجة إلى سفر، والإخبار عن المستقبل بلا اجتياز للزمن، ويقدر على فهم لغات الخلق وإدراك محتواها من دون الحاجة إلى تعلّمها.
عند قطع ربوع العدالة والوصول إلى منزل التقوى يمكن للإنسان إدراك المسائل وتحليلها بالشكل الصحيح في المجالات السياسيّة والاجتماعيّة، وحينئذ لا يكون فتنة للآخرين، ولا يقع في شباك فتن الدنيا الكثيرة (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)[440] «مَن يتّق الله يجعل له مخرجاً من الفتن»[441].
إنّ الله قد وعد المتّقين بالنجاة والفوز الأبديّ، قائلاً: (وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)[442] ولا أصدق من الله حيث يقول: (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا)[443]، (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا)[444] ولا أوفى من الله بعهده: (وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ)[445].
نعم، إنّ مجرّد الدخول في قائمة المتّقين والنجاة من الفتن لا يعني بلوغ الهدف، وإنّما فائدته مجرّد النجاة من الخطر وقطّاع الطريق؛ لأنّ الهدف هو الله}، وبالتقوى يحصل التقرّب منه؛ لأنّها هي التي توصل إليه (وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)[446] والمتّقي قريب من الله.
وكلّما ازدادت التقوى ازدادت سرعة السير لبلوغ الدرجات العليا من القرب الإلهي، وكمال التقوى يتحقّق بكمال العدالة، وكلّما اقترب السالك إلى الهدف ازدادت تقواه وضوحاً ودقّة وعمقاً وعراقة، ولذا قُسّمت التقوى إلى عامّة وخاصّة وأخصّ. وقد جاء ذلك في نظم أحد الحكماء:
|
كدرج
التوب مراتب التقى من حرمة أو حلّ أو دون اللقا[447]. |
وهذا يعني أنّ التقوى ـ كالتوبة ـ لها ثلاث مراتب: التقوى العامّة والخاصّة والأخصّ، فالتقوى العامّة اجتناب الحرام، والتقوى الخاصّة الإمساك عن الحلال بمقدار الضرورة، والتقوى الأخصّ هي الامتناع عن الاهتمام بغير الله، فمن يمتلك مرتبة عليا فهو يمتلك ما دونها لا بالعكس، وملحقات المرتبة العالية لن تكون للمرتبة الدانية.
الجرعة الرابعة: هداية الناس والدفاع عنهم
نهضة عاشوراء كانت استعراضاً للتضحية والإيثار بالنفس، وبذل الغالي والنفيس لهداية البشريّة والدفاع عنها، وقد ضحّى فيها سيّد الشهداء× بكلّ ما عنده؛ لإيصال المجتمع إلى الوحدانيّة لله سبحانه وإلى التفكير الإلهي على أساس التعاليم الإلهيّة، وهذه هي رسالة الأنبياء^ ورسالة ورثتهم، كما قد ورد في زيارة وارث، أنّ الحسين× وارث الأنبياء[448]، وهذا يعني أنّه ذاق المرارة التي ذاقها الأنبياء، كما واجه الصعوبات التي واجهها الأنبياء، وأكمل رحلتهم الجهاديّة والقتاليّة، وعاش تجارب الأنبياء الإصلاحيّة ونجاحاتها وموفّقيّاتها، ففي عصر نوح حدث طوفان عظيم، وفي كربلاء حدث طوفان عظيم أيضاً، كما قال الشاعر:
|
كشتي شكست خوردهء توفان كربلاء[449]. |
وإذا أُلقي النبي إبراهيم× في نار نمرود، فقد تحمّل سيّد الشهداء× نيران نمروديّة ـ أيضاً ـ حيث أُحرقت خيامه على أهل بيته وأصابهم ما أصابهم من النار[450]. وإذا واجه موسى الكليم× أخطار وصعوبات، فقد تعرّض الإمام الحسين× لنفس تلك الأخطار والصعوبات أيضاً، وإذا تحمّل المسيح العذاب والأذى، فقد تحمّل الإمام الحسين× مثلها أيضاً، والرسالة التي كان نوح وإبراهيم وموسى الكليم وعيسى المسيح^ يريدون إيصالها إلى المجتمعات البشريّة هي نفسها الرسالة التي تلقّتها الأمّة من النهضة الحسينية، ولذا نقرأ في زيارة الإمام الحسين×: «السلام عليك يا وارث آدم... يا وارث نوح... يا وارث إبراهيم... يا وارث موسى... يا وارث عيسى...»[451].
موضوعان مهمّان مثّلا عُنصري نهضة عاشوراء بشكل محوري، أوّلهما: الهداية، وثانيها: الدفاع عن الشعب، وهداية الأمّة والدفاع عنها لم يختصّ بالحسين×، بل اشترك في هذه المهمّة كلّ من أتى معه بما فيهم الرجل والمرأة والطفل والشيخ، ويسري الأمر لجميع أصحاب الوعي والمعرفة بالمضيّ قدماً في هداية المجتمع من جانب والدفاع عنه من جانب آخر.
وبناء على هذا الأساس، ركّز سيّد الشهداء× في كلماته وخطبه على هذين العنصرين المحوريّين، فلمّا تكلّم مع معاوية تحدّث حول هداية المجتمع والدفاع عنه[452]، وكان ينادي بهذين العنصرين بعد شهادة الإمام الحسن× والصلح المفروض، وتسليم السلطة الأُمويّة ولاية العهد ليزيد. ولما هلك معاوية وجاء يزيد إلى منصّة الحكم، رفض بيعة يزيد الفاسق، وأعلن عن هاتين الرسالتين لعامله في المدينة، وكان يركّز على إيصال هاتين الرسالتين إلى الأمّة بشتّى الوسائل وفي جميع الأوقات والأماكن ومتى ما سمحت له الفرصة؛ عند خروجه من المدينة إلى مكّة وعند خروجه من مكّة إلى العراق في الثامن من ذي الحجّة، وهذا يعني أنّ نهضة عاشوراء عالميّة وحيّة وخالدة، يستطيع الكل تعقّلها والاستفادة من النهج والفكر الحسيني، كلّ بحسب مقداره، وقد سار الكثير على هذا النهج، وانتفعوا من الفكر الحسيني ولم يقتصروا على اللطم[453].
لا يمكن مشاهدة الصفاء الروحي والمعنوي في البلاد إلّا عن طريق الاستفادة الصحيحة من النهضة الحسينية، فذلك الصفاء الروحي والمعنوي الذي نشاهده في شهر رمضان المبارك حيث أبواب الجنان مفتّحة، وملائكة الرحمة في الفضاء محلّقة، وأبواب النيران مغلقة...، صفاء لا يمكن أن نستشعره ونعيشه في البلاد إلّا من خلال الاستفادة الصحيحة من كربلاء الحسين×.
وكما ينقسم الإسلام إلى إسلام حقيقي يهتمّ بالمبادئ والمظاهر وإسلام زائف لا يهتمّ إلّا بالمظاهر، كذلك تنقسم النهضة الحسينة إلى حقيقية وزائفة، فالزائفة كالتي تكتفي بعرض التشابيه وضرب السلاسل والزناجيل وحمل المنصّات الحديديّة الثقيلة وأمثالها، وأمّا النهضة الحسينيّة الخالصة فأحد مظاهرها ما حصل عام 1978م وأنتج انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران[454].
إنّ المآتم التي تحمل المنصّات الحديديّة الثقيلة والسلاسل بأنواعها والتشابيه كان يحضرها مثل رضا خان ومحمد رضا، وتمثّل مظهراً لكربلاء الأمريكيّة، لا تُوصل إلى غاية ولا يُنال بها فائدة تُرجى، وهذا يعني أنّ كربلاء الخالصة تُخرّج لنا أُناس يشعرون بالمسؤوليّة، وتجذبهم للدفاع عن الحقّ في ميادين الوغى، وكربلاء الأميركيّة تبعث على التحجّر والرجعیّة، وينبغي علينا تقييم المقدار الذي باستطاعتنا أن نغترفه من منهل النهضة الحسينية، فهناك من يطلب الإمام الحسين× لأجل دعاء عرفة ويذرف الدموع عليه، وهناك من يعشقه لآهاته ليلة عاشوراء ويضجّ لأجله، وهناك من ينشده ويبحث عنه لمحاربته للظلم ومواجهته إيّاه، كلّ هذه الأبعاد يجمعها أنّه× (رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)[455] و(كَافَّةً لِلنَّاسِ)[456].
ولم يطمئنّ الإمام الحسين× للكتب والرسائل التي وصلته من الكوفة، ولم يعتمد عليها في أداء وظيفته المتمثّلة بهداية الناس والدفاع عنهم، بل أرسل مَن يطمئنّ ويثق به مسلم بن عقيل مع جماعة إلى الكوفة[457]، ولما أقام مسلم أيّاماً في الكوفة ـ وكان مثالاً رائعاً في الزهد والتقوى ـ وقف ضدّه النعمان بن بشير الذي كان عاملاً عليها من قبل الأُمويين، واستمرّ النعمان بالدعوة إلى الإسلام الأٌموي، وصعد المنبر وأوصى الناس بالتقوى وحذّرهم من الاختلاف والفرقة[458].
وحدثت فوضى واضطرابات في الكوفة، ونكث بعض من كتب إلى الإمام الحسين×، وخذلوا مسلم بن عقيل وتركوه وحيداً[459]، وتوجّه جماعة من أهل الكوفة إلى مكّة.
ولمّا وصل خبر مسلم بن عقيل إلى أبي عبد الله× لاحظه وقيّم الأوضاع ودرسها، ثمّ عزم على التوجّه إلى الكوفة، بالرغم من اطمئنانه بعدم نصرة غالبية أهل الكوفة له، وقد أبدى تبرمه من الذين دعوه إلى زخارف الدنيا وحدائقها، مؤكّداً لهم أنّه بحاجة إلى أناس عطاشى حفاة أمثال دليلي مسلم بن عقيل الذَين ماتا عطشاً في صحراء قاحلة، ليعلن للناس أنّ الإسلام الحسيني منفصل عن الإسلام الأُموي، كما أمر عبد الله بن الحرّ الحنفي الجعفي بالفرار والابتعاد عن كربلاء؛ لأنّه ما من أحد يسمع استنصارنا (هل مِن ناصر ينصرنا) ولم ينصرنا لم يكن من أهل النجاة[460].
وقد شهر الأُمويّون سيف الإسلام الأُموي في وجه مسلم بن عقيل الذي كان يحمل الإسلام العلوي ويدعو الناس إلى التوحيد، ولما دخل ابن زياد إلى الكوفة أرجع الأمور بحيلته السياسية إلى ما كانت عليه، وأصبح هاني بن عروة بعد ضربه وشتمه تحت سيطرته، وطلب شريح القاضي لوجاهته بين الناس، وأمره أن يخبر أهل الكوفة بأنّ هانئاً لم يُقتل، وفرّق الناس[461]، فلمّا أخبر شريح القاضي الناس بأنّ هاني بن عروة حيّ يُرزق تفرّقوا، وبخبر شريح القاضي المتظاهر بالدين ضاعت الفرصة الحسّاسة، فشعر الثوّار المهاجمون الذين اجتمعوا للدفاع عن مسلم بن عقيل بالاطمئنان وانصرفوا.
وبهذه الأخبار الكاذبة استقرّ الأمر لابن زياد، وعزّز موقفه السياسي، وبدأ يستخدم سياسية الترغيب والترهيب، وبقي هاني مضمّخاً وجهه بالدماء[462]، فصلّى مسلم صلاة المغرب في المسجد، واستُغلّت فترة ما بين صلاة المغرب والعشاء لترغيب الناس وتحذيرهم، وتمّ اعتقال مسلم بن عقيل بمؤامرة، وأعلنت السلطة الحاكمة إعلاناً رسميّاً تُلزم فيه حضور الناس جميعاً لصلاة العشاء في المسجد، وجاء ابن زياد وصلّى بالناس صلاة العشاء بإمامته، ثمّ صعد المنبر وخطب فيهم[463]، وهذا يعني أنّ الإسلام الأُموي أصبح في مقابل الإسلام الحسيني، وإلّا فلا يمكن لأحد أن ينتصر على الإمام الحسين×.
وبعد شهادة مسلم بن عقيل نظّم كاتب ابن زياد كتاباً مفصّلاً يُخبر فيه يزيد بما حصل، فرفض ابن زياد، ولم ير حاجة إلى هذا التطويل، وأمره بأن يكتب: «فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّه وكفاه مؤنة عدوّه»[464] وقد ادّعى عبيد الله بن زياد في كتابه هذا الإسلام إلى نفسه، ووصف أهل بيت العصمة والطهارة^ بأنّهم معتدون ومجرمون، والإسلام الذي ادّعاه ليس إلّا إسلاماً أُمويّاً، ولم يكن له حيلة في إهدار دم مسلم بن عقيل، وتبشير قاتله بالجنّة إلّا التلبّس بزي الإسلام.
وكتب الإمام أبو عبد الله× كتاباً لأهل البصرة جاء فيه: «إنّي أدعوكم إلى الله وإلى نبيّه، فإنّ السنّة قد أُميتت والبدعة قد أُحييت، فإن تُجيبوا دعوتي وتُطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد»[465] وهذا يعني أنّكم إن أجبتموني ستهتدون إلى سبيل الرشد، كما قال الله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ)[466] وإذا لم يسلك الإنسان سبيل الرشد وترك محاربة الهوى والأصنام، سيعرف يوم يُكشف له الحجاب أنّه قضى عمره سفيهاً وهو يحسب أنَّه عاقل.
وكتب بنفس المضمون إلى أهل الكوفة وبلاد مصر، وجعلهم على أهبة الاستعداد، وكان متوجّها إلى العراق ومعه جماعة من أصحابه، والتقى بالفرزدق وكان خارجاً من الكوفة، فسأله عن أهلها، فقال: قلوبهم معك وسيوفهم عليك، فقال الإمام الحسين×: لا تنصحني ولا تخوّفني بقلّة الناصر: (لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ)[467]، (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ)[468] «إن نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله ـ سبحانه وتعالى ـ على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء فلم يبعد من كان الحقّ نيّته والتقوى سريرته»[469] ثمّ سأله الفرزدق عن بعض مناسك الحجّ، ثمّ ودّعه وواصل سيّد الشهداء× طريقه إلى العراق[470].
ولمّا خرج الإمام الحسين× من مكّة قاصداً العراق، قد اعترضه جماعة كانوا يخالفونه الرأي، حاولوا ثنيه عمّا يروم، فلم يتمكّنوا[471]، لذا قال لهم: (لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ)[472]. وتوجّه نحو العراق المحفوف بالمخاطر، وترك مكّة بالرغم من أنّ حرمته محفوظة فيها[473].
ولما التقى بالحرّ بن يزيد الرياحيّ، خطب خطبة أخرى، وكتب مرّة أخرى كتاباً إلى أهل الكوفة، وذكر جماعة في صدر كتابه، ثمّ خاطب جميع أهل الكوفة: «أمّا بعد، فإنّ رسول الله’ قال: من رأى سلطاناً جائراً، مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثمّ لم يغيّر بقول ولا فعل، كان حقيقاً على الله أن يدخله مدخله»[474].
وهذا من قبيل ما جاء في القرآن الكريم حينما أراد المستضعفون من الله تعالى أن يُضاعف العذاب على المستكبرين، ولكنَّ الله ضاعف العذاب على المستضعَف والمستكبر معاً، فأمّا المستكبر فلأنّه ارتكب ذنبين، أحدهما: ارتكابه المعصية، والثاني: إضلاله جماعة وتمهيده الأرضية المناسبة لانتشار المعصية في المجتمع، فهو ضالّ ومضلّ، وبما أنّه ارتكب ذنبين فله عقابان، وأمّا المستضعَف فقد ارتكب ذنبين أيضاً، الأوّل: ارتكابه للمعصية التي ارتكبها المستكبر، والثاني: قبوله لولاية المستكبر وإمامته وقيادته ولم يعترض عليه بقول ولا عمل، قال الله : (لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ)[475].
كان سيّد الشهداء× حتّى آخر لحظة من حياته يسعى لهداية الناس، محاولاً تعريفهم بحقيقة الإسلام الأُموي، ولذا فبالرغم من أنّه كان متيقّناً من شهادته، ويعلم بأنّ كتابه لا يصل إلى الناس؛ لأنّ العدوّ سيمنع من وصولها، ولذا لم يكن لديه طريق لإيصال رسالته إلّا بالدم، كما حصل لقيس بن مسهّر الصيداوي[476].
إنّ أكثر الذين جاؤوا إلى كربلاء لقتل الإمام الحسين× من الكوفة والبصرة والقرى المجاورة لهما، كان بداعي التقرّب إلى الله ودخول الجنّة[477]، ولم ينالوا قبل حادثة كربلاء وبعدها جائزة إلّا كيساً من الشعير علفاً لخيلهم، ولذا لما تلى الإمام الحسين×: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ)[478] قالوا: نحن وربّ الكعبة الطيّبون وأنتم ـمعاذ الله ـ غير طيّبين[479]، وهذا الكلام قد قالوه عن عقيدة، ولما أراد الإمام الحسين× منهم أن يكفّوا عنه حتّى يصلّي هو وجماعته، رفضوا وقالوا: إنّها لا تُقبل[480]. وبهذه الأعمال الشيطانيّة انتهت واقعة عاشوراء لصالح بني أُميّة وبخسارة بني هاشم بحسب الظاهر.
وقد التقى سيّد الشهداء× في طريقه إلى الكوفة بعدّة شخصيّات، منها: زهير بن القين، فتأثّر بكلام الإمام الحسين×، وقال لزوجته: أنت طالق كي تكوني حرّة وتلحقي بأقاربي وأصحابي؛ لأنّه بعد شهادة أصحاب أبي عبد الله×، يتمّ أسر وسبي نسائهم، ثمّ قال: كلّ من أتى مع سيّد الشهداء× فقد لحق بالسعادة الأبديّة[481].
ثمّ أشار إلى قصّة حدثت له، قائلاً: إنّا غزونا البحر، ففتح الله علينا وأصبنا غنائم، فقال لنا سلمان&: ـ أفرحتم بما فتح الله عليكم وأصبتم من الغنائم؟ فقلنا: نعم، فقال: إذا أدركتم سيّد شباب آل محمّد، فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه ممّا أصبتم اليوم من الغنائم[482].
إنّ تزكية الناس هي أحد أهداف سيّد الشهداء× وأصحابه، ولذا نقرأ في زيارة وارث الأنبياء: «طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم»[483] أي: إنّكم طاهرون وتُطهِّرون حياة الأمّة التي تربّي الشهيد، إنّ بعض الناس طاهرون، لكن ليس لديهم القدرة على تطهير الآخرين؛ لأنّه ليس كلّ طاهر فهو مطهِّر، فالماء المضاف طاهر، ولكنّه ليس بمطهِّر، وأمّا الماء المطلق فهو طاهر ومطهِّر، والشهيد طاهر ومطهِّر أي: إنّه يعدّ الأرضية المناسبة لتطهير حياة المجتمع، لا تطهير كلّ أرضه؛ وذلك لأنّه قد يُدفن كافر إلى جنب الشهيد كما هو الحال في أرض كربلاء، فإنّها أصبحت مدفناً للشهداء ومدفناً للكفّار أيضاً، لكن الجانب الذي دُفن فيه الشهداء أصبح يُتّخذ منه تربة يُسجد عليها في الصلاة، والسجدة عليها تصعد إلى عنان السماء، ولكنّ الجانب الآخر الذي دُفن فيه الكافرون لا أثر له.
القرآن الكريم يرى أنّ الأرض الطيّبة تُنتج ثماراً طيّبة بإذن الله تعالى (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ)[484] إنّ تربية الشباب المتديّن هو ـ أيضاً ـ ثمرة الأرض الطيّبة التي طهرت بدم الشهداء، كما أنّ النظام الإلهي الإسلامي وجميع الأراضي التي يسيطر عليها هذا النظام، إنّما هو نتيجة دماء الشهداء والإرادة الشعبيّة لتحقيق حلم الأنبياء، فهذا النظام شجرة طيّبة غُرست وسُقيت بدم الشهداء.
يرى القرآن الكريم طهارة الروح من ثمار الشجرة الإنسانيّة الطيّبة التي (أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ)[485]، وفي مقابل هذه الشجرة الطيّبة شجرة خبيثة: (اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ)[486].
إنّ الشهيد سواء غرق أو فُقد، وسواء رجع جسده أو لم يرجع، فإنّه سيُطهِّر الأرض الإسلاميّة، ذلك أنّ طهارة الأرض تتحقّق بعنصرَين محوريَّين: النظام وإسلاميّته، ويجب أن يُعلَم أنّ انتصار النظام الإسلامي إنّما هو من ثمار دماء الشهداء وببركتهم[487].
إنّ تطهير الناس وتزكيتهم أمر واجب، ولذا قال الله تعالى لليهود: بما أنّكم غير خالصين لا يمكنكم إقامة الكتاب السماوي: (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ)[488]. وهذا يعني إنّكم لا تستندون إلى ركن وثيق، وأنتم واقفون على شفا جرف هار، أو على كثيب مهيل، ومن يقف على ذلك لا يتمكّن من حمل شيء ثقيل[489]، وبما أنّ القرآن قول ثقيل (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا)[490] ونزوله يُصدّع الجبل (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)[491]. فحامله ـ وكذا حامل الوحي والتوراة والإنجيل ـ لا بدّ أن يمتلك القاعدة الفكريّة العميقة للتوحيد الخالص، ولكنّ مَن ترتجف قدماه ولا يقف على أساس ثابت محكم، فإنّه لن يقوى على حَمل هذا الوزن الثقيل.
إنّ القرآن الكريم عطاء فكريّ وعقائديّ للناس، منحهم القوّة والثروة لتظهر جمهوريّة خالصة تعتمد على ذلك الدين الخالص، وأمّا إذا كان الدين والقائد خالصة ولكنّ الدولة غير خالصة، ستتكرر نفس الواقعة التي حصلت في صدر الإسلام، بالرغم من وجود القرآن الكريم والعترة الطاهرة: «ارتدّ الناس بعد النبي’ إلّا ثلاثة نفر»[492].
فالشهداء قافلة الجنّة، وركب ملكوتيّ لا يتوقّف عن الحركة دائماً، وخلال تلك الحركة يُعرف الإسلام الخالص مرةً، ومرةً أخرى الجمهوريّة الأصيلة، وهذا ما سعى إليه الإمام الحسين× من أجل تطهير الناس وتزكيتهم، وما اعتلى في جميع أنحاء الكوفة شعار (يالثارات الحسين)[493] إلّا بعد تطهير الناس وتزكيتهم، ولم يمض وقت طويل حتّى غادر الأُمويّون وتقوّضت سلطتهم[494]. ولا زالت نهضة كربلاء ـ منذ ذلك اليوم وحتّى الآن ـ مشعلاً ونبراساً لثورات كثيرة[495].
الجرعة السادسة: الوصول إلى قيادة الشعب
يعلّمنا القرآن الكريم كيف علينا أن نطوي مراحل المعرفة والهجرة والمسارعة والتسابق، وهذا يعني أنّ البداية تكون في معرفة الحقّ وتشخيص الصراط المستقيم وتمييز القبيح من الحسن والخير من الشرّ، وبعد اجتياز مرحلة المعرفة تبدأ مرحلة الهجرة، ثمّ تبدأ مرحلة المسارعة (وَسَارِعُوا)[496]، ثمّ تأتي بعد ذلك مرحلة السباق (سَابِقُوا)[497]، وأمّا ما كان مورداً للتكاثر ينبغي ترك التسابق فيه، مع ترك الطمع ومدّ البصر إلى ما في أيدي الناس من متاع الدنيا وزينتها، حتّى يصدق عليهم قوله تعالى: (هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا)[498] واجتناب السعي لامتلاك الأفضل ممّا عند الآخرين من فراش وبيت وأثاث؛ لأنّه مرض، وهو عبارة عن درجة من حبّ التكاثر، ظاهره خدّاع وباطنه سمّ قاتل. الصحيح أن يتمّ التسابق بين أهل الكوثر إذ إنّه لازم في جميع درجات العلم والعدل والتقوى والزهد كي يحظى بإمامة المجتمع الأفضل (وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)[499] فإنّ نيل إمامة المتّقين من أفضل الأمنيات المنبثقة عن العقلانيّة.
وأينما دار الحديث حول معطيات نهضة كربلاء سنجد في صدر القائمة إحياء الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويلزم من نسيان النهضة الحسينية أضرار وخيمة، تؤدّي إلى ذلّة الشعوب وانتشار الفتن والشغب والفساد في الأرض.
وتوضيحه: لقد ذكر القرآن الكريم نوعين من الحكومة؛ العادلة والظالمة، وذكر أنّ من آثار الأولى: إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولقاء الله وبلوغ الهدف؛ لذا قال: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)[500]، وهذا يعني أنّ الحكومة العادلة المتمثّلة برجال الدين لا تقتصر على إقامة الصلاة، بل تسعى للقضاء على الفحشاء والمنكر في المجتمع (...إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ... )[501]. وأمّا الحكومة الثانية فمِن آثارها الهرج والمرج والفساد في الأرض والفتنة والشغب وذلّة الشعوب (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً)[502].
إنّ الإنسان لديه فطرة بها يوحِّد الله تعالى، وبها يطلب الفضيلة والكمال، وجُبل على طبيعة تميل به نحو الرذائل (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ)[503]، فيُنمّي الأنبياء الجوانب الفطريّة للإنسان، ويبقى عليه الإصلاح للجوانب الطبعيّة على ضوء ازدهار الفطرة، ولا ينبغي تعطيلها وإلّا ستخلق المشاكل.
إنّ القادة الإلهيين يسعون إلى إيصال المجتمع البشري إلى درجة بها يصبح وارث الحسين بن علي÷؛ لأنّه إذا وصل المجتمع إلى هذه الدرجة صار وارث الأنبياء^.
يُستفاد من كلام أمير المؤمنين× في خطبته القاصعة أنّ المادّيين كانوا يحكمون في الشرق الأوسط قبيل إبراهيم× وآمنوا بالعبوديّة للطبيعة، ولمّا جاء إبراهيم× رأى الأوضاع مناسبة للنهضة التوحيديّة، فدخل الميدان وبدأ بمواجهة إلحادهم بسلاح الموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن وبالدليل والبرهان، ولمّا لم يؤثّر ذلك استعان بالفأس وحطّم أصنامهم (فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا)[504]، فنهض الملحدون للدفاع عن آلهتم ونصرتها وحرق إبراهيم بالنار (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ...)[505]، وقد صبر إبراهيم× على وعيدهم هذا حتّى أنجاه الله تعالى من النار (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ)[506]، وبعد اجتياز هذه الامتحانات المختلفة أعطاه الله تعالى الإمامة (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[507]
وبما أنّ إبراهيم× على رأس قائمة الأنبياء الإبراهيميين، وقد شكّل الحكومة، فبعد أن وصل إلى مقام الإمامة طلب من الله تعالى إعطاء هذا المنصب للأنبياء من ذرّيته، ليبقى هذا المصباح الوهّاج مستمرِّاً في ذرّيته، وإنّما طلب هذا المنصب؛ لأنّه منصب كماليّ، وليس متاعاً دنيويّاً لا قيمة له.
استمرّت حكومة هذه السلالة، وجاء داوود وسليمان وموسى واحداً تلوى الآخر، وحارب كلّ واحد منهم فرعون عصره، وخلّصوا الناس من ظلم أولئك الفراعنة وسطوتهم (وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا)[508]، ولكن لمّا جاء الدور إلى خَلَفِهم لم يعرفوا الحقّ، ومالوا من العلم إلى الجهل، وتركوا العدل وارتكبوا الظلم، ولم يراعوا حقّ ذلك النظام، وارتُکبت الجرائم، وکما جاء في الخطبة القاصعة فإنّ الأكاسرة والقياصرة الذين كانوا قوى عظمى في ذلك الزمان، تسطلّوا على ذرّية إبراهيم، وبسبب تشتّتهم وضعفهم وفسادهم جعلوهم إخوان (دبَر ووبَر)[509].
فقال أمير المؤمنين×: بعد أن ابتلى أسلافكم بهذا المصير، نهض النبي الأكرم’، وأقام الحكومة الإسلاميّة، وغلبتم الفرس والروم، وأصبحتم أعزّة[510]، إنَّ هذا الدهر يمضي، وإن تزرع شرّاً تحصد شرّاً، والأمر إليكم وبيدكم (وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا)[511]، و(وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ)[512] فأيّ طريق اخترتموه ستسير المشيئة الإلهيّة طبقه، فأمير المؤمنين× كان يحذّرهم من تركه لوحده، ويحثّهم على الصبر والصمود في حرب العدو، وإلّا سيُسلّط عليكم مَن أنتم أحقّ منهم[513]، وكان كما قال×، حيث سلّط الله عليهم الحجّاج، وأصبح هذا التنبّؤ حقيقة[514].
إنّ مَن يقف ضدّ الأولياء هم الملوك والسلاطين، وإذا دخلوا أرضاً أفسدوا فيها، وأذلّوا عزيزها وأعزّوا ذليلها، فيرتكبون أعمالاً تنافي القسط والعدل (قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ)[515]، وهذه الآية جاءت على لسان ملكة سبأ، ولم ينقد القرآن الكريم كلامها، بل أمضاه وأقرّه.
فالأمّة متى ما أهملت دين الله وتخلّت عن المراكز الدينيّة، وتعاملت مع سيّد الشهداء× الذي يمنح الشرف والعزّة والكرامة والحرّية بسطحية، ستخضع وتستسلم أمام هجوم الأعداء بلا ريب[516].
ينبغي للإنسان أن يغتنم فرصة المناجاة مع الله} والمثول بين يديه في الصلاة؛ لأنّ الدنيا دار زوال متصرّمة، ينبغي أن لا يُتوهّم دوامها، والحياة كنهر متدفّق ولكلّ شخص نصيبه منه (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ)[517].
فإذا تغيّرت الدنيا وانقلبت أحوالها، تضايق مَن يعتقد ثباتها، وصار يشتم ويكيل للدهر السباب واللعن، غافلاً عن كونها متصرّفة بأهلها من حال إلى حال، وجيل يأتي وآخر يذهب، والأدوار تمرّ بسرعة[518]، فينبغي اغتنام هذه المدّة القصيرة، ونأخذ منها متاعاً إلى الحياة الأبديّة كي نعيش حياة طيّبة، ونموت موتة حسنة، ونُحشَر يوم القيامة سعداء مسرورين.
إنّ الإمام موسى الكاظم× لمّا رأى قبراً، قال: «إنّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن يُزهد في أوّله، وأنّ شيئاً هذا أوّله لحقيق أن يُخاف آخره»[519]، وبناء على هذا يجب على الإنسان ان يمضي في طريقه باحتياط منذ البداية، ويواصل مسيرته بدقّة، ويعيش حياته بحكمة.
لقد أدرك العلماء الربّانيّون الراسخون بصورة جيّدة أنّ الدنيا محطّة، ولكلّ إنسان مدّة محدودة لا يتجاوزها، فالعمر ينقضي أوّله بسكرة الصبا والشباب، وآخره بالأمراض والعلاج، فلا يبقى إلّا وسطه، ولذا تجد العارفين بزمانهم قد اغتنموا أعمارهم، ومن دون لعن الدهر وشتمه، ونالوا في الدنيا متاع سفر الآخرة.
لو أخبرنا خبير مختصّ بأمور المباني بأنَّ هذا البيت آيل للانهيار في وقت قريب، سنقطع بصدق كلامه، ونرتّب عليه الأثر، وخالق هذا العالم لا يوجد أصدق منه (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا)[520]، فهو تعالى قد أخبرنا أنّ الدنيا ليست دار قرار واستقرار، يعيش فيها الإنسان حياة مليئة بالعناء (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ)[521]، وامّا الحياة السعيدة المرفّهة فهي في مكان آخر، لا ينالها إلّا بالسعي والعمل الصالح في الدنيا، وإن انحرف الإنسان وقطع الطريق على أحد، فلن ينال الأمن والاطمئنان في المستقبل أبداً.
فمن لا يفهم أسرار العالم، ولا يتّعض بنصيحة الأولياء وعلماء الدين، ظانّاً أنّه سينال بالوهم والخيال حياة هادئة مطمئنّة، فكأنّه نائم لا يدري أنّ الدنيا مزلّ الأقدام، وأنّه سيواجه المتاعب لا محالة (فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ)[522].
وإذا أذعن الإنسان وصدّق بأنّ الدنيا نهر دائم التغيير، وإلى الله تُرجع الأمور، والفوز والفلاح في النهاية للمتّقين (وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ)[523] سيعيش حياته بعقل وحكمة، وهذا يعني لو حكم أولياء الله لتدبّروا شؤون المجتمع على أساس العقل والعدل، وعاشوا هم والمجتمع حياة سعيدة مرفّهة (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)[524].
الجرعة السابعة: الإيثار والصمود حتّى الشهادة
يجب على الأمّة الإسلاميّة أن تصمد في سبيل الحقّ، ولا تهاب الموت، وهذه الرسالة من أهمّ مبادئ وأُصول نهضة عاشوراء، وبرزت حينما حُدّد الموقف النهائي تجاه الركب الحسيني، وهو صدور الأمر من دار إمارة الكوفة إلى الحرّ بن يزيد الرياحي، يأمره بالتشديد على الإمام الحسين×، وأن يضطرّه إلى العراء في غير خضر وعلى غير ماء (فجعجع بالحسين)[525]، أي: لا تسمح له بالرجوع إلى المدينة أو التوجّه إلى الكوفة أو نواحيها، ولا تسمح له بالتوجّه إلى أماكن فيها المياه وظلال الأشجار وسفوح الجبال؛ ليضطرّ إلى نصب خيامه في الصحراء القاحلة، وأُمر الرسول الذي جاء بهذا الكتاب من ابن زياد بمراقبة الأوضاع ومدى تطبيق الحرّ لما أُمر به، وأن يكتب إلى ابن زياد بما يصنعه الحرّ، ولذا حينما قال سيّد الشهداء× للحرّ: دعنا ننزل في نينوى، أجابه الحرّ: أنّي مأمور أن أُسايرك إلى مكان خال من المُعين[526]، عند ذلك خطب سيّد الشهداء× خطبة غرّاء، قال فيها: «لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفرّ فرار العبيد»[527]؛ لأنّ ما يصنعونه ببدن مَن رحل عن هذه الدنيا لا يُعدّ ذلّة له؛ لأنّ العزّة والذلّة، والإيمان والكفر، والعقل والجهل، والفسق والعدل، صفات تعرض على الروح لا البدن، وليس بذليل مَن دافع عن نفسه ودينه بعزّة ونال الشهادة، وما البدن إلّا تبع للروح، فإذا كانت الروح عزيزة كريمة ستبقى كذلك وإن تعرّض البدن للتمثيل والجرّ بالأسواق والأزقّة كبدَني مسلم وهاني.
وإنّ المقطع الثاني في كلام الإمام الحسين× الآنف الذكر إن كان هو «لا أقرّ لكم إقرار العبيد» والإقرار هو الاعتراف، فهو مرادف في المعنى للمقطع الأوّل «لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل»، وإن كان المقطع الثاني: «لا أفرّ فرار العبيد» من الفرار والهروب، فهذا المقطع يُفسّر لنا الكثير من التعبيرات الأخرى، وهذا ينفي بضرس قاطع ما نقل ـ ممّا لا أصل له ـ من أنّ الإمام الحسين× حاول النجاة بنفسه من الموت[528]؛ ذلك لأنّه قد سئم من الجور والظلم المستشري، ومن كان هذا حاله لا يَقرّ له قرار، ولا يجد نفسه آمناً من هذا الظلم أينما حلّ، سواء لجأ إلى جبل أو لاذ بقرية.
فكلّ نقل تاريخي لا يتّفق مع هذه الخطوط العامّة، فهو مخالف لسيرة سيّد الشهداء×، وضعيف وفاقد للحجّية، ولا ينبغي أن يذكر، وهذا يعني أنّ سيّد الشهداء× كان يبذل قصارى جهوده لإحياء الدين، وقد وصل إلى هدفه، وقد تمّ التخطيط لهذه المهمّة في عالم الرؤيا الصادقة المتصلة بالمثال المنفصل والملكوت؛ لأنّ النبي الأكرم’ قد أمره في الرؤيا بالذهاب إلى العراق مصطحباً معه نساءه وشبابه وأطفاله[529]، وقام الإمام الحسين× بتجسيد تلك الرؤيا على الواقع، وأخرجها من العلم إلى العمل، ومن المسموع إلى الملموس[530]، وهذا الموقف الذي اتخذه الإمام الحسين× هو السبب في إيقاظ ضمير الأمّة في جانب مهمّ من الشرق الأوسط، ولو لم يصطحب الإمام الحسين× معه الأهل والعيال لمَا أُسروا وسِير بهم إلى الكوفة والشام، ولمَا اطلع الأُمويّون على حقائق النهضة، ولمَا ثار أهل الكوفة والشام، ولمَا فهم الناس من المدينة حتّى الشام هذه النهضة، ولولا ذلك لبقيت هذه النهضة الحسينية ناقصة، ولأُقبرت في الكوفة والبصرة، ولذا طلب النبي الأكرم’ من الحسين× أن يصطحب معه من يمتلك لساناً ذرباً بليغاً، وهذا ما يقتضي التأمّل في ما قيل من أنَّ الإمام الحسين× أذن لأصاحبه بالانصراف ويأخذون معهم أهل بيته[531].
لن يسمح سيّد الشهداء× أبداً بلجوء السيّدة زينب وبقيّة النساء والأطفال إلى القرى المجاورة للنجاة من الأسر؛ لأنّ في أسرهم حلّ لكثير من مشاكل المجتمع الإسلامي آنذاك، وعلى تقدير أنّ الإمام× أجاز لبعض الأصحاب تسريح نسائهم، فلعلّ السبب في ذلك يعود إلى ثقلهن على القافلة وعدم الجدوى؛ لأنّ مظلوميّة الأسير لا تحلّ بمفردها سبات المجتمع، وإنّما تُحلّ بالخطب المؤثّرة التي من خلالها يتمّ الوصول إلى المطلوب، ولذا لم يسمح الإمام الحسين× بنقل عياله إلى مكان آخر لتخليصهم من الأسر، قائلاً: «شاء الله أنْ يراهنّ سبايا»[532].
وقد أوصى أبو عبد الله× العيال والأطفال بضبط النفس، وتجنّب الشكوى والكلام الذي يحطّ من شأنهم، وترك كلّ ما يحطّ من منزلتهم قولاً وعملاً، قال×: «ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم»[533]؛ لأنّنا قوم نريد إحياء المجتمع الميّت، وإعزاز الذليل، وتقوية الضعيف، وتحرير العبيد، وهذه الرسالة تفتح القلوب المقفلة، وتشرح الصدور الضيّقة بالأخلاق الكريمة والآداب النبيلة، وهذا ما جسّدوه في الواقع، وبالرغم من النوح والبكاء والحزن والأسف بلحاظ الجانب العاطفي، إلّا أنّ رضوان الله سبحانه كان مصدر طمأنينة وهدوء لهم وروح وريحان.
كان سيّد الشهداء× يحثّ الناس على لقاء الله، والشهادة في سبيله، وترك الحياة مع الظالم الجائر، فإنّها حياة مريرة تعيسة، لقد بكى الإمام الحسين× كأبيه أمير المؤمنين× على مظلوميّة الإسلام، وما كان من شأنه أن يبكي لأمور عاطفيّة أو غربة أو ظلم يقع عليه، بل كان وجهه يزداد نوراً وبشاشة كلّما دنى وقت شهادته[534]، وهذا يدلّ على أنّه لا يذرف الدموع من أجل حوادث الدنيا الزائلة.
ويوم عاشوراء أصاب صدر الحسين× سهم ذو ثلاث شعب، وبما أنّه كان يشتمل على نتوءات ما حاول الإمام إخراجه من الأمام؛ إذ سيخرج معه كلّ قفصه الصدري؛ لذا فقد انحنى وأخرج السهم من ظهره، ولم يُنقل أنَّ الإمام الحسين× قد بكى في هذه الحالة: «فأتاه سهم مسموم له ثلاث شعب، فوقع على قلبه...، ثمّ أخذ السهم فأخرجه من وراء ظهره»[535].
ولم يرو أحد أنَّ الإمام× بكى حينما كان ينقل جثامين الشهداء إلى الخيمة، لكنّه× بكى بكاء شديداً لمّا رأى دين الله} في حالة احتضار، وأنّ القوم قد رفعوا راية الإسلام الأُموي بدلا من راية الإسلام العلوي، وحكموا باسم الإسلام.
وبناء على هذا فكان لبكاء سيّد الشهداء× دوافع راقية، ولا ينبغي تفسيره بداع عاطفي؛ لأنّ الموحِّد حينما يتضجّر من ظلم الحكومة وجورها يشرح صدره لمبارزتها ويستأنس بمحاربتها.
نعم، على الأمّة الإسلاميّة أن تأخذ الدروس والعبر من صمود الإمام الحسين× ومقاومته حتّى الشهادة؛ لأنّ في ذلك سعادتها.
الجرعة الثامنة: الإقدام على أساس العلم الموجب للتكليف
قال رسول الله’ للإمام الحسين× في عالم الرؤيا: «يا حسين، اخرج فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً»[536]، وهذا يعني أنّ سيّد الشهداء× كان يعلم بشهادته، وهذا الأمر قد دعا العلماء والمحقّقين للتحليل والبحث وتمييز العلم الموجِب للتكليف عن العلم الذي لا يوجب التكليف، فإذا كان الإمام الحسين× متيقّناً من شهادته وأسر عياله، فلماذا أقدم على هذا العمل الخطير؟ فهل أنّ علم المسلم بالغيب يوجب تكليفاً أو لا؟
إنّ النهضة الحسينية تُعبّد طريقاً أمام المحقّقين والباحثين ليدركوا أنّ علم الغيب ليس منشأً للتكليف الفقهي، في هذه النشأة (الدنيا)يجب الوصول إلى علم قائم على أساس الحجّية المتعارفة، وأمّا علم الغيب الشبيه بعلوم الملائكة فهو خارج عن مجال التكليف، ولا يمكن العمل به كتكليف، إذن فأساس حركة الأُمّة الإسلامية علم يُكتسب في عالم الشهادة، رغم أنّ العلم الملكوتي يُستخدم أحياناً لإظهار المعجزة أو الكرامة.
الجرعة التاسعة: تقوية العزيمة العمليّة
كانت إرادة سيّد الشهداء× وعزيمته بادية في جميع نقاط النهضة وجوانبها، فكان يدعو الأُمّة الإسلاميّة إلى العزيمة، فإنّه قد يفهم الإنسان أمراً اعتماداً على قواعد الاستدلال وأصوله، ولكنّه بما أنّه لم يذعن له فقد لا يقوى على فعل شيء، وبيان ذلك: هناك سلسلة من المفاهيم كالتصوّر والتصديق والقطع والظنّ والوهم، وأمثالها من شعب العقل النظري، وبواسطتها يتمّ الحصول على مجموعة من المسائل العلميّة، وهناك مفاهيم أُخرى كالإرادة والعزم والنيّة والإخلاص تتعلّق بمحفّزات العقل العملي، والجزم والقطع النظري وإن كان ضروريّاً لتحفيز العقل العملي ولكنّه لا يكفي، وهذا يعني أنّه لو كان الإنسان جازماً معتقداً بأنّ جهاد أعداء الدين من فروع الدين كالصلاة والصوم والحجّ، لكنّ عقله مغيّب وغافل، وإذا غفل العقل الذي هو «ما عُبد به الرحمان واكتسب به الجنان»[537] انتقضت إرادة الإنسان وعزيمته على الجهاد؛ لأنّ العقل أحياناً قد يستسلم لنوم الغفلة: «نعوذ بالله من سبات العقل»[538].
وعلى هذا الأساس يجب على الإنسان تقوية عزيمته؛ ليتمكّن عملياً من بيان أنّ دينه أعزّ من دنياه، وأنّه على أتمّ الاستعداد للتخلّي عن كلّ شيء للحفاظ عليه، ويستثمر كلّ شيء لأجله، وبهذا يستطيع أن يقول: إنِّي ما أرى الموت إلّا سعادة والحياة مع الظالمين إلّا برماً، وإنّي أرى هذه الحياة سيّئة، بل أمقتها. وسيّد الشهداء× نموذج كامل لهذا المعنى؛ لذا يدعونا أن نتعلّم منه كيفيّة الحرب: لأنَّي أمتاز بحاسّة ذوق بها أشخّص مرارة العيش في الأجواء الملئية بالظلم، وبحاسّة شمّ بها أميّز الرائحة النتنة المنبعثة من الحياة في نظام قائم على المعصية، فالطائر الذي فقد أجنحته وريشه، لايقوى على الطيران، وأصبحت رؤيته محدودة، وفقد حاسّتي الذوق والشم، وسُجن في قفص ذي رائحة نتنة، وما عاد يميّز النظام المفتوح من المغلق، وأمّا أنا الذي أتمكّن من التحليق فقد سأمت وضاقت بي الحياة، وصمّمت على التحرّر، وما لم يتجرّع الناس غصّة الاختناق، ويشعروا بالقدرة على الطيران، ويسأموا من الحياة، لن يتمكّنوا من القتال أبداً، وهذه المسألة لا تُحلّ بمجرّد حصول (القطع) نظريّاً، بل حلّها الوحيد يكمن بالعزم والإرادة.
إنّ قدوة الأُمّة الإسلاميّة في جانبها السلوكي هو سيّد الشهداء×، ومن المظاهر العمليّة لذلك سيرته× وشهامته مع أعدائه، ومنها أنّه قد ادّخر ماءً كثيراً خلال حركته لاحتمال انضمام بعض الأشخاص إليه أثناء الطريق[539]، وفي اليوم التالي هناك من كبَّر من أصحابه، فسأل الإمام× عن سبب التكبير، فقال: كأنّي أرى جذوع النخل، فقال الآخر: إنّها ليست جذوع النخل، وإنّما هي الخيل والأسنّة والرماح، فهو جيش كبير مقبل إلينا، وهي تُرى للناظر كأنّها نخيل[540].
وقد توجّه الإمام× مع من معه إلى ربوة مرتفعة، فوصل الحرّ مع ألف فارس، عندها أمر الإمام الحسين× أصحابه أن يسقوهم الماء، ويرشّفوا الخيل ترشيفاً، قال علي بن الطعان المحاربي: «كنت مع الحرّ يومئذ فجئت في آخر مَن جاء من أصحابه، فلمّا رأى الحسين× ما بي وبفرسي من العطش، قال: أنخ الراوية والراوية عندي السقاء، ثمّ قال: يا بن أخي، أنخ الجمل، فأنخته، فقال: اشرب، فجعلت كلّما شربت سال الماء من السقاء، فقال الحسين×: اخنث السقاء، أي: اعطفه، فلم أدر كيف أفعل، فقام فخنثه فشربت». ثمّ قال فاذهب إلى حيث شئت، وبما أنَّه حان وقت الصلاة، فقال× لهم: صلّوا صلاتكم ونصلّي صلاتنا، فقال الحرّ: بل تصلّي فنصلّي بصلاتك، وقد صلّى الجميع صلاة الظهر بإمامة سيّد الشهداء× [541].
لكنّ هؤلاء الناس أنفسهم لمّا رأوا الحسين× وأصحابه عطاشى يوم عاشوراء، قالوا: «والله، لا تذوق منه قطرة واحدة حتّى تموت عطشاً»[542].
نعم، هناك اختلاف كبير بين السلوك العلوي الحسيني النبيل وبين السلوك الأُموي والمرواني الدنيء. شهيد كربلاء كان شهماً نبيلاً وقد دعا الأمّة الإسلاميّة عملياً إلى النبل والشهامة.
الجرعة الحادية عشرة: إثارة دفائن العقول
قد خلق الله الإنسان وأودع في نفسه العقل والفطرة ليصبح خليفته، وأرسل نماذج من خلفائه في أرضه للحفاظ على هذه المنزلة من الضياع، ولتنظيم أفكار الإنسان وهدايته، وأُولئك الخلفاء هم الأَنبياء، وأيّدهم بالكتب السماويّة القيّمة لقيادة البشريّة (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)[543]، ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)[544]، ولكن بما أنَّ الطغاة وقطّاع الطرق وقفوا أمام أولياء الله فلا يمكن حلّ المشكلة بالخطب والمواعظ والكتب، ولذا قد يتطلّب الأمر أحياناً إراقة الدماء، ووطأ الأجساد بحوافر الخيل، والصبر والتسليم عند سلب الخيام وحرقها، وهذه التضحيات قد مرّ بها جميع الأنبياء.
حينما وهب الله لموسى مقام الرسالة كلّفه بالذهاب إلى فرعون وإخباره بأنّه مبعوث لهداية الناس، لا لتملّك كنوز الأرض، ولذا كان جوابه حينما سأله رجال البلاط الفرعوني عن سبب ثورته ونهضته، أخبرهم بأنَّ خلفاء الله بُعثوا ليثيروا للناس دفائن عقولهم ويعرّفوهم طاقاتهم... «ويثيروا لهم دفائن العقول»[545]، ولا يمكن أداء هذه الوظيفة دون الاعتماد على رجال ملتزمين قادرين، ولا تحظى بهذا الفوز العظيم أيّ جماعة مبتلية بعبادة الطغاة: (أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ)[546]. لقد أُرسل الأنبياء من قبل الذات الإلهية المقدّسة لتحقيق أهداف سامية رفيعة، منها (إثارة دفائن عقول الناس)، وعمد فرعون إلى خداع الناس بطرحه فكرة أنَّ موسى يريد تغيير دينكم: (إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ)[547].
المجتمع الإنساني كسلسلة جبال في باطنها معادن مختلفة: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة»[548] والخبير يعلم أيّ جواهر قيّمة قد دُفنت في وسط هذه المعادن، وهذه الكنوز ليست مادّية ومعدنيّة، بل كنوز عقليّة لا يمكن تثمينها بالذهب والفضّة؛ لأنّ الذهب والفضّة حجران أحدهما أصفر والآخر أبيض، ويزعم البشر إنَّ لهما قيمة «فإنّهما حجران»[549]. ولذا نجد أنّ الإمام الباقر× لمّا شبَّه أصحابُه كلامَه بالجواهر، قال لهم: وهل الجوهر إلّا حجر، ولذا ورد في الحديث: «ودخل إليه سفيان الثوري يوماً، فسمع منه كلاماً أعجبه، فقال: هذا ـ والله ـ يا بن رسول الله الجوهر، فقال له: بل هذا خير من الجوهر، وهل الجوهر إلّا حجر»[550]، وبالرغم من أنّ الذهب والفضّة أحجار قيّمة مادّياً باعتبارها (أحجار كريمة)[551]، لكن لا يمكن أبداً تشبيه المعارف الدينيّة بتلك الأحجار، لأنّها معلومات ما وراء الطبيعة، تبني الإنسان وتجعله ملكوتيّاً، وتَعدّ له زاداً ومتاعاً أبديّاً، فإذا تحطّم قفص الطبيعة حلّق مع الملائكة، وتظهر ملائكيّته عند أوقات المناجاة مع الله}، ويرى ذلك الإنسان الجالس على ماء الحياة، وماء الحياة هذا يفجّره الأنبياء من ينابيع الباطن الإنساني.
|
هرگز
نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ثبت
است بر جریده عالم دوام ما[552]. |
یشتمل باطن الإنسان على دفائن عقليّة نفيسة، وينابيع غزيرة بماء الحياة، ومن المؤسف جدّاً أن يسلبها الفراعنة.
إنّ زيارة أمين الله تدلّ على أنّ الأئمّة المعصومين^ هم أمناء الله عموماً وأمير المؤمنين× خصوصاً[553]، والناس ليسوا كالأشجار أو الأحجار أو البحار أو الأراضي التي لا قيمة لها، بل الناس في أعماقهم فطرة إلهيّة، ويمكنهم أن يرتقوا إلى مصافّ الملائكة إذا أودعوا هذه الأمانة عند الأمين الإلهي، بل قد يسبقون الملائكة، إذن فلِمَ يأتمنوا عليها الأبالسة والشياطين[554]؟! ولا يزيحوا قطّاع الطريق عن الهيمنة عليهم؟!
نقرأ عند سيّد الشهداء×: «السلام عليك يا وارث موسى كليم الله»[555]، وهذا يعني أنّك ـ أيضاً ـ أمين إلهي كموسى×، وجئت لتكشف دفائن عقول المجتمع البشري وتثيرها، وتهب العقلانيّة لمن يطلبها، وتروي العطاشى بماء الحياة، وتبيّن لهم بأنّ قيمتهم على قدر عقولهم ومعرفتهم.
كان الإمام الحسين× يؤكّد للناس بأنّ سلاطين بني أُميّة قد غيّبوا أعلام الهدى، وطمسوا معالم الدين، وسلبوا الناس أمنهم، وأفسدوا في البلاد، وعطّلوا الحدود، ويُذكّر الناس بما سمعه عن النبي’، حيث قال: «مَن رأى منكُم سُلطاناً جائِراً مُستحلاً لحرم الله، ناكثاً بعَهدِه، مُخالِفاً لسنّةِ رسولِ الله، يَعملُ في عبادِه بالإثمِ والعدوانِ، فلم يُغيّر عليهِ بقولٍ ولا بفعلٍ، كان حَقّاً على الله أن يُدخِله مَدخلَه»[556]. ولذا قال في مناجاته مع الله تعالى مبيّناً سبب خروجه: «لنُري المعالم من دينك، ونُظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك»[557].
وكان الإمام الحسين× يؤكّد على حقيقة، وهي أنّ الموت والشهادة شرف وسعادة، وليس في الموت عار ولا منقصة، ومَن لا ينصر الإمام× لا يبلغ الفتح والسعادة[558]. فوقف سيّد الشهداء× كموسى الكليم بوجه فرعون وهامان وقارون الذين يرمزون لثلاثة نماذج من الظلم، ومن هنا نتأدّب بين يديه ونقول: «السلام عليك يا وراث موسى كليم الله»[559] أي: إنّك قد حاربت فرعون عصرك، كما نقول أيضاً: «إنّي سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم»[560]، ونقول في زيارة الجامعة أيضاً: «فالحقّ ما حقّقتم، والباطل ما أبطلتم»[561] وهذا يعني أنّنا على المستوى الثقافي نسير وفقاً لمنهجكم العلمي، وعلى المستوى العسكري نعادي أعداءكم، وهذا هو منهج التشيّع. إذن فالإمام الحسين× إمام كربلاء، والمجتمع الإسلامي أُمّة كربلاء أيضاً، ورسالة الإمام× إحياء دفائن العقل النظري على الصعيد الفكري، ودفائن العقل العملي على مستوى التحفيز والتحريك.
قال أمير المؤمنين× في أحد كتبه الغزيرة بالمعاني الراقية والنورانيّة التي جاءت في نهج البلاغة: «إنّي سمعت رسول الله’ يقول في غير موطن: لن تُقدّس أُمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القويّ غير متتعتع»[562]، وهذا يعني أنَّ الشعب الذي لا يتمكّن من أخذ الحقّ للضعيف، ولا يستطيع المظلوم أن يتكلّم فيه بحرّية لا يستحقّ التقديس، وفي وصف القائد الإلهي قال الإمام الحسين×: «ولعمري ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط»[563] أي: إنّ الحاكم لا بدّ أن يكون عارفاً بالإسلام داعياً له، مديراً مدبراً عادلاً قائماً بالقسط، والإيمان بهذه المبادئ والأصول يُعدّ من دفائن العقول، والبحث عن هذه المبادئ والأصول يتطلّب جهوداً وأبحاثاً علمية متظافرة؛ لأنّ دفائن العقل لا يمكن العلم بها والعثور عليها بسهولة؛ لأنّها مستورة من الخارج بحجب البصر والسمع والذوق واللمس والشم، ومحجوبة من الداخل بغطاء القوى المتخيّلة والواهمة والحسّ المشترك والخيال، ولهذا أصبح بعض الناس كثيروا الوهم، وبعضهم من أهل الخيال، وطائفة ثالثة لا يتجاوزون الحسّ، وجميع هؤلاء يعيشون خارج دائرة العقل، ولايهتدي الإنسان إلى دائرة العقل ما لم يعمل على تعديلها، ولهذا وصف القرآن الكريم مَن يعيش في دائرة الخيال بأنّه مختال فخور: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)[564]، ومن كان مختالاً بالفعل عاقلاً بالقوّة فهو كمن امتلك كنزاً لكنّه ينام جائعاً. وبهذا اتضحت واحدة من مهامّ القادة الإلهيّون، وهي هداية الناس إلى حقيقة العقل وتحريكهم، وزيادة فعّاليّتهم بإطلاعهم على ما يمنعهم من ذلك من الأمور.
الكأس الثالث: متجرّعو مصائب كربلاء
الجرعة الأولى: عظم وصعوبة مصائب كربلاء
إنّ مصائب سيّد الشهداء× عظيمة جدّاً، وقد بلغت من العظم درجة لا يستطيع تحمّلها جميع أهل السماوات والأرض، وهذا ما أكّدته المصادر، كما ورد في زيارة عاشوارء: «لقد عظمت الرزيّة، وجلّت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض»[565]، وقد صبر الإمام الحسين× على جميع تلك المصائب وتحمّلها.
إنّ عظم مصيبة كلّ إنسان على قدر كرامته، فمن عاش في بلد معزّزاً مكرّماً، يصعب عليه أن يعيش مشرّداً هو وعياله، وإن كان تعامل النساء مع الرجال الأجانب بالمقدار المشروع كالسلام والسؤال والجواب والبيع والشراء، يُعدّ أمراً طبيعيّاً بالنسبة إلى عامّة الناس، إلّا أنّه قاس وصعب جدّاً بالنسبة لمن لم تكن نساؤهم هكذا فلا رآهن أجنبيّ ولا تحدّث معهن قط، وروي: أنّ أمير المؤمنين× قال: «نُبّئت أنّ نساءكم يخرجن إلى الأسواق، ويزاحمن العلوج، ويدافعن الرجال في الطريق، أمَا تستحون؟»[566]، إنّ هذه الأمور قد لا تكون مهمّة بالنسبة إلى عامّة الناس وضعفاء الإيمان، ولكنّها شاقّة جدّاً بالنسبة إلى أهل بيت الوحي^، وكم هو عظيم عليهم أن تضطرّ نساؤهم للتحدّث مع الأجانب. إذا عرفنا منزلة الأئمّة المعصومين^ جيّداً، سيتّضح للجميع عظم ما جرى من مصيبة في كربلاء.
وتجدر الإشارة هنا إلى أمرين في غاية الأهمّية:
الأوّل: إنّ هدف أهل البيت^ إحياء الدين، وإعلاء كلمة التوحيد، ودفع الظلم ورفعه، وتحرير المجتمعات البشريّة من قيود الشرك الظاهري والباطني على المستوى العقائدي، وإقامة القسط والعدل على المستوى الفردي والاجتماعي، فقد اتصف أهل البيت× بالعصمة والكرم، وعاشوا حياة عزيزة كريمة، ومَن يتصف بهذه الصفات ويعيش هكذا حياة يصعب عليه ـ جدّاً ـ التشرّد.
روى أبو خالد الكابلي، وهو من شيعة الإمام السجّاد×: وقع في قلبي الذهاب إلى الإمام السجّاد×، فلمّا وصلت هناك استغربت لمّا رأيت باب الدار مفتوحاً ـ ما كان ترك الباب مفتوحة يتنافى مع الثقافة العامّة آنذاك، إذ من المحتمل أن يقع نظر المارّة على مَن في المنزل وهو دون حجاب ـ فاستأذنت للدخول، فأذن لي ودخلت على الإمام زين العابدين×، فقلت: سيّدي هناك ما أثار دهشتي، لقد كان باب الدار مفتوحاً! فقال الإمام×: لقد خرجت الخادمة ونسيت أن تُغلق الباب، ولا يجوز لبنات رسول الله’ أن يبرزن فيصفقنه، وحتّى البنات الصغيرات من أهل البيت^ حينما يخرجن من الدار يغلقن الباب، ولكن تلك الخادمة لم تكن من أهل بیت الوحي فتركت باب الدار مفتوحاً[567].
والغرض أنّ أبا خالد الكابلي تعجّب لمّا رأى الباب مفتوحاً؛ لأنّ ذلك خلاف عادتهم، وأخبره الإمام× بإنّ أهل بيت النبي’ لا يدعون الباب مفتوحاً، وعليه فمَن تحلّى بهذه الآداب، وقضى عمره وعاش حياته بهذا النحو من العزّة والكرامة، كيف ستكون معاناته حينما يصبح أسيراً بيد الأجانب، يطوفون به من مكان إلى آخر؟ إنّ تحمّل هذا الأمر صعب جدّاً، ولهذا كان يذبّ شباب بني هاشم عن بنات الرسالة غيرة وحميّة ورعاية وصوناً لهنّ من الابتلاء بمثل هذه المصائب.
وكنموذج آخر، يروي لنا يحيى المازني: حينما كنت أسكن في المدينة بجوار أمير المؤمنين×، كان كلمّا أرادت إبنته السيّدة زينب‘ الخروج لزيارة قبر رسول الله|، تقدّم أمير المؤمنين× أمامها، والإمام الحسن× عن يمينها، والإمام الحسين× عن شمالها، وساروا بكلّ جلال وعظمة، فإذا دنوا من القبر الشريف أخمد أمير المؤمنين× القنديل، فلم أعرف السرّ في ذلك، فسألته عن سرّ هذا الأمر فقال×: أوّلاً: نوصل زينب بكلّ عزّة وإجلال، وثانياً: حتّى لا يرى أحد شخصها‘ [568].
هذه المرأة العظيمة التي قد تربّت في منزل الوحي ومهبط الملائكة، دخلت إلى الكوفة بثياب لا تتناسب مع عزّتها، «عليها أرذل ثيابها»[569]، ولمّا رأت هذا المشهد لا حيلة لها إلّا أن تشقّ جيبها «أهوت إلى جيبها فشقّته»[570]، ولطمت وجهها عندما رأت يزيد ينكث ثنايا أبي عبد الله بالخيزرانة.
الجرعة الثانية: فضل البكاء على الحسين ×
قال سيّد الشهداء×: «أنا قتيل العَبرة»[571]، كما وصفت بعض الروايات والزيارات الإمام الحسين× بقتيل العبرات[572]. والعَبرة هي الدموع الغزيرة التي تذرفها العين وتسيل على الخدّين[573]، ولذرف الدموع على سيّد الشهداء× أجر عظيم.
وجرت سيرة الرسول’ والأئمّة المعصومين^ ابتداءً من أمير المؤمنين×، وحتّى الإمام صاحب الزمان# على البكاء على سيّد الشهداء×، ولا زالت هذه السيرة قائمة، بل حتّى الحسين× بكى على نفسه[574]؛ لأنّ شهادته كانت مفجعة محزنة تستحقّ البكاء، فمدرسة الحسين× مدرسة البكاء على فقدان العقل ونسيان العدل. فإنّ من يحبّ شخصاً يبكي عليه، وهذا يعني أنّ البكاء وذرف الدموع عمليّة عاطفيّة، ولكنّها تستبطن أحياناً آثاراً ونتائجَ جيّدة، مثلاً: من نتائج البكاء على الشهداء الشجاعة وطلب الشهادة.
إنَّ النبي الأكرم’ إنسان كامل لا يأتي الزمان بمثله، ولا نظير له في الخلق، فهو مصداق قوله تعالى: (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ)[575]، وقد بكى مراراً على الإمام الحسين× قبل شهادته بخمسين عاماً[576].
ولغرض إفهام الناس مظلوميّة الإمام الحسين× وأهدافه السامية بكاه النبي’ في مناسبات مختلفة ومواضع متعدّدة[577]. وكان يجلس في إحدى الغرف ويقول أحياناً: لا يدخل عليَّ غير الحسين× [578]، وعندها لا يحقّ لأحد أن يمنع الحسين× من الدخول عليه، ويجلس الإمام الحسين× أحياناً على صدر رسول الله|، فيحمله ويبكي، فسئل عن سبب بكائه، فقال: قد أتاني جبرائيل فأخبرني بشهادته، فكان يقال له أرنا التربة التي يُقتل فيها، فكان رسول الله’ يريها لهم، ويفتح يده المباركة ويقول: إنّ ما ترونه في يديّ هي تربة ولدي الحسين. وقد أعطاها إلى أمّ سلمة[579].
كان الناس يرون رسول الله| في المجالس العامّة ينزل من على منبره، فيحمل الحسين× ويأخذه معه إلى المنبر، ولكنّهم لم يطّلعوا على سرّ هذا العمل، وما اتضح ذلك السرّ إلّا بعد حدوث واقعة كربلاء ذلك الحدث التاريخي الذي حصل بعد مرور أكثر من خمسين عاماً.
وکان رسول الله’ أحياناً يفتح قميص الإمام الحسين× ويقبّله في نحره، ويشمّه في صدره، ولم يفعل هذا ببقيّة أحفاده[580].
وبكى الإمام أمير المؤمنين× في حرب صفّين حينما رجع الإمام الحسين× من ميدان الحرب منتصراً، فسألوه عمّا يبكيه وقد فتح الله على يد الحسين× ورجع سالماً؟ فأجابهم أمير المؤمنين×: سيأتي يوم يبرز فيه إلى القتال ممتطياً فرسه، ثمّ يعود الفرس بلا فارسه، وإنِّي بكيت لذلك اليوم[581].
ولقد بكى الإمام الحسن المجتبى× على مصائب أخيه أبي عبد الله الحسين×[582].
إنّ أهل بيت أبي عبد الله× وعوائل أصحابه قد شاهدوا تلك المصائب المفجعة التي جرت في كربلاء، وما إن تذكّروا تلك المصائب إلّا واختنقوا بعَبَراتهم، وما فتئ الإمام السجّاد× يبكي لأكثر من ثلاثين عاماً على سيّد الشهداء×، وكلّما أراد الوضوء ورأى الماء بكى، بالرغم من أنّ الإمام كان معصوماً لا يختلف عن بقيّة الأئمّة^ في الشؤون العامّة للإمامة، وقد روى ابن طاووس عن الإمام الصادق×: «إنّ زين العابدين× بكى على أبيه أربعين سنة، صائماً نهاره، قائماً ليله، فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه، فيقول: كلّ يا مولاي، فيقول: قُتل ابن رسول الله’ جائعاً، قُتل ابن رسول الله عطشاناً، فلا يزال يكرّر ذلك ويبكي حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله}»[583].
وروي أنّ الريّان بن شبيب دخل على الرضا× في أوّل يوم من المحرّم، فوجد الإمام× مغموماً مهموماً، فسأل الإمام× عمّا يغمّه ويحزنه، فأخبره الإمام× بأنّ هذا اليوم هو اليوم الأوّل من محرّم، وتذكّرت مظلوميّة ومصيبة سيّد الشهداء فبكيت، ثمّ قال: يا بن شبيب، إن كنت باكياً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب÷ [584]. وهذا يعني أنّه لا يوجد أمر يستحقّ البكاء غير الحسين بن علي× وأهدافه السامية، فالبكاء على غير سيّد الشهداء ليس له أهميّة من الناحية العقليّة والعلميّة.
وخاطب الإمام صاحب العصر والزمان# جدّه الحسين×، قائلاً: «فلأندبنَّك صباحاً ومساء، ولأبكينَّ عليك بدل الدموع دماً»[585]، ثمّ يذكر الإمام# مصيبة الإمام الحسين×، قائلاً: «وأسرع فرسك شارداً، وإلى خيامك قاصداً محمحماً باكياً، فلمّا رأين النساء جوادك مخزيّاً، ونظرن سرجك عليه ملويّاً، برزن من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات، وبعد العزّ مذلّلات، وإلى مصرعك مبادرات»[586].
يلزم استذكار مصائب سيّد الشهداء× والبكاء عليه لأدنى ملمّة، وينبغي من عوائل الشهداء والمعاقين أن يتذرّعوا بمصائبهم للبكاء على مصائب الإمام الحسين×، ويبكون على سيّد الشهداء×؛ لأنّه قال: «أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني»[587]، فلا ينبغي العكس بأن يُجعل مصاب الإمام الحسين× ذريعة للبكاء على الأهل والأحباب.
ولا بأس بالإشارة إلى عدّة ملاحظات حول البكاء على سيّد الشهداء×:
1ـ البكاء على سيّد الشهداء× عبادة، ويترتّب عليها ثواب عظيم[588].
2ـ البكاء رغم كونه حالة عاطفية لكنّها حكيمة، وبالنسبة لبعض الوالهين حالة من العشق؛ إذ ينشأ إثر ذلك نحو من الارتباط والمحبّة بين الباكي وشهداء كربلاء، مشكّلاً مقدّمة وأرضيّة لإحياء سيرتهم كالشجاعة والاستشهاد في سبيل الله، على أنّ هذا الارتباط له أثر بالغ يفوق ما تُنتجه الدروس والبحوث النظريّة، فالبكاء على سيّد الشهداء× في الحقيقة هو بكاء على البسالة والنضال المتمحّض لإحياء أصول الدين كالتوحيد والإمامة، وفروع الدين كالعدل والإحسان، ولذا فإنّ هذا النوع من البكاء يُلهم الباكي روحاً حماسيّة.
3ـ إنّ البكاء على الشهيد يصبّ في منفعة المجتمع، والشهيد في غنىً عن ذلك.
4ـ إنّ ثواب البكاء على سيّد الشهداء× كثواب زيارته. والأحاديث الواردة في زيارة الإمام الحسين× على نحوين: روايات مطلقة لم يرد فيها قيد (المعرفة)، وروايات مقيّدة بالمعرفة، من قبيل قوله×: «من زاره عارفاً بحقّه...»[589]، ولا يصحّ حمل الروايات المطلقة على المقيّدة للجمع بين هاتين الطائفتين، لنستنتج من ذلك أنَّه لا أجر للعزاء والزيارة بلا معرفة بحقّ الإمام، بل الروايات الآنفة الذكر تدلّ على تعدّد المطلوب، وأنّ كلّ من المطلق والمقيّد مطلوب في حدّ ذاته، وهذا يعني أنّ الأجر يحصل بمجرّد الزيارة والبكاء وإقامة العزاء، وأمّا إقامة العزاء المقرون بالمعرفة فهو أكثر ثواباً، وأكمل أجراً، وكذلك الأمر بالنسبة للزيارة التي هي المحور الأصلي للروايات، ولكنّ هذا لا يعفي من ضرورة المعرفة الإجماليّة على أقل التقادير.
5ـ عند رقّة القلب تنفتح أبواب الرحمة الإلهيّة، وبما أنّ القلب ينكسر بسرعة عند ذكر مصيبة سيّد الشهداء×، وجب اغتنام هذه الفرصة جيّداً وطلب الحاجة من الله أثناءها.
الجرعة الثالثة: مكانة وشرف الحائر الحسيني
إنّ للحائر الحسيني الشريف حكماً فقهيّاً خاصّاً، مثل الحرم الإلهي، وحرم النبي الأكرم’، وهو أنّ المسافر مخيّر في ذلك الموضع بين القصر والتمام[590].
لقد سعى الأئمّة^ ـ بطريقة وأخرى ـ لإحياء ذكر كربلاء، ومن ذلك ما روي: «أنّ الصادق× مرض، فأمر مَن عنده أن يستأجروا له أجيراً يدعو عند قبر الحسين×، فوجدوا رجلاً، فقالوا له ذلك، فقال: أنا أمضي، ولكنّ الحسين إمام مفترض الطاعة، وهو إمام مفترض الطاعة! فرجعوا إلى الصادق× وأخبروه، فقال: هو كما قال، ولكن أمَا عرف أنّ لله تعالى بقاعاً يُستجاب فيها الدعاء، فتلك البقعة من تلك البقاع»[591].
ونظير ذلك ما ورد عن الإمام علي بن محمد الهادي×، أنّه لمّا مرض، وحضر أبو هاشم عنده، قال له الإمام×: أرسل أحد شيعتنا إلى كربلاء ليدعو لي بالشفاء في الحائر الحسيني، مع أنّ المسافة لم تكن شاسعة بين بيت الإمام× وكربلاء، وقد أمر أبو هاشم رجلاً من الشيعة لينفّذ أمر الإمام الهادي×، لكنّ ذلك الرجل طرح سؤالين دقيقين:
السؤال الأوّل: أليس الإمام الهادي× أفضل من كربلاء؛ لأنّه عدل الإمام الحسين×، والحائر الحسيني ما هو إلّا مكان دفن الإمام الحسين×؟
السؤال الثاني: كيف أدعو للإمام× وأنا أقلّ شأناً منه؟
فتحيّر أبو هاشم في إجابته، فسأل الإمام الهادي× عن ذلك، فقال: إنّ الله لا يستجيب الدعاء في كلّ مكان، والحائر الحسيني هو موضع يُستجاب فيه الدعاء[592].
ويستفاد من بعض الروايات إختصاص الإمام الحسين× بعدّة أمور:
1ـ الإمامة في ذرّيته.
2ـ الشفاء في تربته.
3ـ استجابة الدعاء عند قبره الطاهر[593].
إنّ الأحداث المنقولة التي يرويها المؤرّخون وأرباب المقاتل عن سيّد الشهداء× وبقيّة المعصومين^ ومَن ينتسب إلى بني هاشم وأصحابه وغيرهم، على طائفتين:
1ـ معتبرة السند، وهي على نحوين:
أـ قطعيّة السند، وهذا يعني أنَّ أسنادها لا محذور فيها قطعاً.
ب ـ ظنّية السند، فإن لم تكن منافية للعقل والتعاليم الدينيّة، يجوز نسبتها بشكل ظنّي إلى أهل البيت^، ولا يجوز شرعاً نسبتها إلى أهل البيت^ بنحو قطعي.
2ـ لا سند لها، وهي ـ أيضاً ـ على نحوين:
أـ لسان المقال، المشتمل على مضامين تنسجم مع العقل والتعاليم الدينيّة ومؤيِّدة لهما، فلا مانع من إسنادها ونسبتها بشكل ظنّي إلى أهل البيت^، وأمّا إذا لم ينسجم مضمونها مع قواعد العقل والشرع، وبالتالي يكون موهِناً للإسلام ولمنزلة الإمامة الرفيعة، فلا يجوز إسنادها ونسبتها بنحو من الأنحاء.
ب ـ لسان الحال، سواء صرّح به أم لم يصرّح، وهذا ـ أيضاً ـ على النحوين الآنفي الذكر في لسان المقال، وحكمه من حيث جواز الإسناد وعدمه كالأحكام والشروط التي ذكرناها في (لسان المقال).
الجرعة الرابعة: أحداث مكّة حتّى كربلاء
قد اجتاز الإمام الحسين× أكثر من عشرين منزلاً في سفره من مكّة إلى كربلاء، وأوّل هذه المنازل هو التنعيم (ميقات الإحرام للعمرة المفردة لمن كان في مكّة).
وقد أشار عبد الله بن عمر على الإمام الحسين^ بأنّ هذا العمل ـ أي: التوجّه إلى الكوفة ـ خطير جدّاً، ومن الأفضل تركه، ولكنّ الإمام× لم يهتمّ لكلامه وواصل سيره، ولمَّا غادر منزل التنعيم نزل في موضع يقال له: (الصفاح)، يبعد عن التنعيم عدة فراسخ، والتقى هناك بالفرزدق بن غالب الشاعر، فسأله الإمام× عن أوضاع الكوفة، فأجاب: «قلوبهم معك، والسيوف مع بني أُميّة، والقضاء ينزل من السماء»، وهذا الكلام من الفرزدق حسن، ولكنّه قطرة في بحر، وأجابه الإمام الحسين×: «لله الأمر، والله يفعل ما يشاء...، وإن نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله...، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يعتد مَن كان الحقّ نيّته والتقوى سريرته»[594].
وبما أنّ الإمام× قد ملأت عقيدة التوحيد كيانه، وكان الحقّ نيّته والتقوى سريرته وهو إمام التقى، أجابه بهذا الجواب، والإمام× وإنْ سُلّتْ عليه السيوف لا يواجه ضرراً مادامت سريرته التقوى، ونيّته الحقّ.
المنزل الثالث ذات عرق، وفي هذا الموضع قد وصل كتاب عبد الله بن جعفر ـ زوج السيّدة زينب الكبرى‘ ـ إلى الإمام الحسين×، ومضمون الكتاب: ليس بصالحك أنْ تخرج بلا ناصر ولا معين مقابل جيش الأُمويّين الجرار فتقتل نفسك، وقد أرسلت إليك ولدي، وسألحق بك إن شاء الله، ولكنّي أنصحك بترك الخروج، وإنِّي سأطلب لك الأمان من والي مكّة[595].
فذهب عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد العاص والي مكّة، وطلب منه أن يكتب كتاباً فيه أمان للحسين بن علي، وقد كتب والي مكّة أماناً، استنكر فيه على الحسين× أن يكون سبباً لشقّ عصى المسلمين واختلافهم، وأعطاه الأمان[596].
فلمّا وصل كتاب والي مكّة إلى الإمام الحسين×، أجابه× جواباً قاطعاً حاسماً، وكان جوابه بهذا المضمون: إنّما خرجت لأدعو إلى الله، وليس في هذا شقّ لعصا المسلمين، وعلى المسلم أن يلحق بي، ولا حاجة لي بأمانك، فخير الأمان أمان الله[597].
وقد اشتمل كتاب عمرو بن سعيد العاص ـ حاكم مكّة ـ على عنصرين:
العنصر الأوّل: أنّه قال للإمام الحسين×: لا تشقّ[598] عصا المسلمين وتوجِد الفرقة بينهم، وهذا يعني دع الحجّاج يتوجّهون حاليّاً إلى عرفات ومنى، ولا تذهب إلى العراق وتدعو الناس إليك.
العنصر الثاني: إنِّي أُعطيك الأمان في مكّة.
فأجابه الإمام الحسين×: «أمّا بعد، فإنّه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله ـ (وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)[599]وقد دعوت إلى الأمان والبرّ والصلة، فخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا. فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة...»[600].
وقد تناول الإمام الحسين× في جوابه هذا كلا العنصرين اللذين ذكرهما عمرو بن سعيد العاص في كتابه:
العنصر الأوّل: ما يتعلق بإثارة الفرقة: إنّي على صراط مستقيم وأدعو إلى الله، لكنَّكم قد ابتعدتم عن الإسلام والصراط المستقيم، وهذا الكلام الذي صدر من الإمام× فيه إشارات إلى حقائق قرآنيّة سامية، أوّلاً: إنّ الله قال في كتابه الكريم: (فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ)[601]، ومعنى الآية: يا رسول الله، بشّر الذين يصغون إلى الأفكار والآراء المختلفة، ويتمتّعون بقوّة التمييز واختيار الأفضل، ولديهم إرادة وعزم على اتخاذ القرار واختيار الأحسن.
وثانياً: قد بيّن الله} لنا ما هو القول الأحسن والأفضل بقوله: (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)[602]، فمَن يدعو الناس إلى الله بالبرهان والدليل، ومَن كانت سنّته وسيرته الإسلام قولاً وعملاً، فقوله أحسن وسنّته وسيرته أفضل. ولذا وصف الرسول الأكرم’ نفسه وأتباعه الخلّص، قائلاً: (أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي)[603]، واعتماداً على هذا عرّف الإمام الحسين× نفسه على أنّه مصداقاً لهاتين الآيتين الكريمتين.
فالإمام× ردّ على كلام عمرو أأنت تحذّرني من الشقاق والاختلاف! وأنا الذي أتحدّثُ عن الوحي الصحيح والصريح! بيد أنّكم قد ابتعدتم عنه، نحن ندعوا الناس إلى الله تعالى، وأنتم تدعونهم إلى الأصنام والوثنيّة باطناً، نحن من المسلمين وأنتم من فرقة أخرى، عملنا صالح، وعملكم طالح، نحن لم نوجد الفرقة والاختلاف، وإنّما أنتم مَن شقّ عصى المسلمين.
نعم، دعوة الحسين بن علي× هي دعوة النبي الأكرم’، وهذا أحد معاني قول النبي الأكرم|: «حسين منّي»[604]، أي: أنّ أبا عبد الله× كرسول الله’ في استدلاله وبرهانه المقتبَس من القرآن الكريم، فهو يدعو الناس إلى الله تعالى، ويعمل صالحاً، ويصدّق عمله قوله، وحينما يقول: (إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ)[605] أي: أنّه مسلم منطقاً وخُلقاً وقولاً وعملاً، ومَن كان هذا منطقه وسلوكه لا يدعو إلى الاختلاف والفرقة.
العنصر الثاني: إعطاء الأمان، فإن كان مقصودك أمان الآخرة فهذا خارج عن قدرتك، وإن كان المقصود الأمان الدنيويّ فلا فائدة فيه؛ لأنّ مَن يأمن في الآخرة من العذاب الإلهي هو فقط مَن كان في الدنيا خائفاً من عدم أداء مهامّه الشرعيّة «ولن يؤمن الله يوم القيامة مَن لم يخفه في الدنيا»[606] فمن لا يخاف من الله تعالى في الدنيا لا يحظى بالأمن الإلهي في الآخرة. فمن أين لك القدرة في هذا الأمر حتّى تعطيني الأمان!
كان هذا هو جواب الإمام الحسين× على كتاب (والي مكّة) الذي كان مقتدراً آنذاك، وفي أوج قوّة الحكومة الأُمويّة.
إنَّ الإمام الحسين× الذي كتب هذا الكلام في كتاب رسمي للأُمويّين كان يُذكِّر مَن معه بقصّة شهادة النبي يحيى×، وكأنّه يقول لهم: نحن نسير على منهج يحيى، وعيسى، وموسى، وإبراهيم الخليل^، بينما يسير أعداؤنا على منهج بني إسرائيل. فكان الإمام الحسين× لا تمرّ مناسبة إلّا وقال هذه الجملة: «من هوان الدنيا على الله أنّ رأس يحيى بن زكريا أُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل»[607]، وهذا يعني أنّ الإمام الحسين× يريد أن يُعلم الجميع ويقول لهم: إنّ رأسي سيُهدى إلى بغي أُمويّ وهو يزيد «خرجنا مع الحسين× فما نزل منزلاً ولا ارتحل منه إلّا ذكر يحيى بن زكريا وقتله»[608].
وكان× يُذكّر بهذا الكلام ما سنحت له الفرصة بذلك كي يُفهِم الجميع مَن هم الذين وراء ستار الحكومة، ومَن هم الذين يسيرون على نهج النبي يحيى×، ومَن الذين يسيرون على نهج بني إسرائيل. ومن أجل إعطاء الصبغة الشرعيّة العامّة لهذه الحركة، وإعلام الجميع بذلك، قام الإمام الحسين× بتوديع قبر النبي الأكرم’ عدّة مرّات لمّا أراد الخروج من المدينة، ولربّما أحيى ليله بالعبادة أحياناً، طالباً تحديد تكليفه من رسول الله’، حيث قال: «السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، فرخك وابن فرختك، وسبطك والثقل الذي خلّفته في أُمّتك، فاشهد عليهم ـ يا نبي الله ـ أنّهم قد ذلّوني وضيّعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتّى ألقاك»[609] فلم يقل للنبي الأكرم’: «وأنا ابن علي بن أبي طالب»، ولكن بما أنّ فاطمة الزهراء‘ حبيبة رسول الله وبضعته، وكان يقول في حقّها: «يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها» «ومَن غاظها فقد غاظني، ومَن سرّها فقد سرّني»[610]، عبّر بقوله: أنا فرخك وابن فاطمة، فما هو تكليفي، فأتاه الجواب الملكوتي في عالم الملكوت «أُخرج إلى العراق»[611]، وخذ معك العيال والأطفال: «إنّ الله شاء أن يراهنّ سبايا»[612]. فإنّ الإسلام ـ حاليّاً ـ يمرّ بوضع لا يمكن تغييره بالخطب أو بالشهادة وحدها من دون الأسر، وقد تلوّث قسم كبير من بلدان الشرق الأوسط، كالحجاز والعراق والشام وما تضمّنته الأراضي الشاسعة بينها، ولتطهير هذه المناطق لا يوجد طريق إلّا أن يُطاف برؤوس شهداء كربلاء في هذه البلدان الإسلاميّة؛ لتتمهّد الأرضيّة المناسبة لهداية جزء كبير من تلك البلدان، وهذا ما حصل بالفعل، حيث تجلّت الحقيقة لأهالي العراق والحجاز والشام، إذ كانت هذه البلدان آنذاك تُعدّ الأكبر والأهمّ والأقدر من بين بلدان الأمّة الإسلاميّة، وحتّى أوامر الحكومة الإسلاميّة كانت تصدر من تلك البلدان، ومن ثمّ تُوجَّه إلى الناس في البلدان الأخرى.
ووصل الركب بعد ذات عرق إلى منطقة الحاجر التي تتوسّط المسافة بين العراق ومكّة، وفي هذا المنزل أرسل الإمام الحسين× قيس بن مسهّر الصيداوي إلى أهالي الكوفة[613]، وذكر الإمام× في كتابه لهم: قد وصلني كتاب مسلم بن عقيل، وقد توجّهت إليكم من مكّة في اليوم الثامن من ذي الحجّة، وذهب قيس متوجّهاً بكتاب الإمام الحسين× إلى الكوفة، ولكنّه قد أُسر أثناء الطريق، وأُخذ إلى ابن زياد، فهدّده بالقتل إذا لم ينل ـ والعياذ بالله ـ من الحسين بن علي و... ، وإذا لم يُظهر العداوة لهم، ويسبّ أهل بيت العصمة والطهارة^.
ثمّ أمره بأن يصعد ويمدح بني أُميّة، ويُثني عليهم أمام الناس، وينال من أهل بيت العصمة والطهارة، ويتبرّئ منهم فقبل قيس بذلك، وصعد المنبر، وقال للناس: إنّي رسول الحسين× إليكم، وقد خلّفته في الحاجر، وهو مقبل إليكم، فاستعدّوا لنصرته، وقد أمرني ابن زياد أن أسبّ أهل البيت^، ولكنّي أسبّ بني أُميّة وألعنهم، ثمّ لعن بني أُميّة وصلّى على أهل البيت× وأثنى عليهم، ورماه جلاوزة بني أُميّة من أعلى القصر إلى الأرض، فتكسّرت عظامه ونال الشهادة[614].
فلمّا وصل خبر قيس بن مسهّر الصيداوي إلى أبي عبد الله× تحمّل وصبر، ولم يبدر منه× إلّا الثبات والاستغفار، وذلك لأنّ الإمام× يرى أنّ هذه المصائب غنيمة وليست خسارة، وكلّ تضحية وإيثار في هذا الطريق يُعدّ جوداً وكرماً، ومن جانب فإنّ هذا الحدث هو مظهر إلهي، والله} «لا تزيده كثرة العطاء إلّا جوداً وكرماً»[615] لأنّ الإمام× كلّما ازدادت المصائب عليه، يقول: «لم تولني إلّا الجميل»[616]؛ لأنّه يرى نفسه قريباً من الله.
فهكذا إنسان كامل لا ينصدم ولا يتضرّر بهذه الحوادث المؤلمة، ولذا حينما قالوا له: إنّ الأوضاع غير مناسبة في اليمن والحجاز والعراق، قال لهم: «لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية»[617].
فإنّ الإمام× حينما تحرّك من مكّة إلى الكوفة وكربلاء قد أخبر بشهادته، حيث قال: «من كان باذلاً فينا مهجته، وموطّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا»[618].
وأشار إلى هذا المضمون عندما وصل وسط الطريق واسترجع قائلاً: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)[619] فإنّ هذا الكلام هو رسالة تدلّ على أنّه ليس متوجّهاً إلى الموت، بل متوجّهاً إلى إحياء الدين، وفكّ الأمّة من قيود الأسر، فإن صدر منه كلام حول الموت فهذا لا يعني أنّه خائف أو قلق من الموت، بل من باب إفهام الآخرين أنّ نهاية هذا الطريق هو الموت، فعلى الذين يخافون من الموت ترك اللحاق بنا، فإنّ هذه القافلة تسير والمنايا تسير معها[620]، ولكنّ نتيجة هذا المسير إحياء الدين والعقل والعدل.
بناء على ما ذكره الطبري قد وصل رسول من الكوفة إلى الإمام الحسين×، فأخبره بشهادة مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، وذكّره بعدم وفاء أهل الكوفة، وهنا نشير إلى كيفيّة شهادة مسلم بن عقيل:
كان السفير الأوّل للإمام الحسين× مسلم بن عقيل يعرف أهل الكوفة جيّداً، ومطّلعاً على ما صنعوه بعلي بن أبي طالب× والحسن بن علي÷، ولكنّه ذهب إليهم لإتمام الحجّة عليهم؛ لأنّ هؤلاء الأولياء كان همّهم إحياء الحقّ، وقد أُحيي الحقّ بهم، وأرادوا إيصال كلمة الحقّ إلى جميع العالم، وقد استطاعوا إيصالها.
وحدث في الكوفة هرج ومرج، ولم يأوِ أحدٌّ من أهل الكوفة مسلم بن عقيل إلّا طوعة التي تربّت وتعلّمت من المدرسة الفاطميّة، وقد رحّبت به في بيتها بكلّ حفاوة[621]. فمدينة الكوفة لم تكن آمنة في تلك اللحظات، وكانت هذه المرأة واقفة على باب بيتها تنتظر ولدها الذي أبطأ في الرجوع، أثناء ذلك جاء رجل غريب وطلب منها الماء، فناولته الماء، وأرجعت الإناء إلى بيتها، ولكنّها لمّا رجعت رأته مايزال واقفاً على الباب، فسألته: ما سبب وقوفك على باب داري، فقال لها مسلم: يا أمة الله، إن عرفتيني فهل تؤمنيني، فقالت له: مَن أنت؟ فقال: أنا مسلم بن عقيل، فرحّبت به، وأدخلته بيتها، وأفردت له غرفة، موطّنة نفسها على تحمّل العواقب[622]، كانت طوعة من نساء الكوفة اللّاتي قد تربين على يد سلالة الطيب النبوي والطهر العلوي[623].
لقد اشتمل سلوك مسلم بن عقيل على مجموعة من التعاليم الإرشاديّة:
بعد ما بايع مسلم بن عقيل جمع كبير من أهل الكوفة باعتباره الممثِّل عن إمام زمانهم[624]، وقد سلّموه أموالاً كثيرة بعنوان (سهم الإمام)، وقد احتفظ مسلم بهذه الأموال عنده[625]، وبما أنّ الوصيّة عند الموت واجبة على من كان في ذمّته حقّ الناس أو حقّ الله، قام مسلم بن عقيل بعدّة أمور:
أوّلاً: بعد أن شهد بوحدانيّة الله، وبنبوّة الرسول الأكرم’، وأحقّية جميع أحكام الدين، أوصى وصيّته، وذكر أنّه علىه دين في الكوفة، وأنّكم لم تنتصروا عليّ في الحرب كي يحقّ لكم أن تأخذوا أموالي غنيمة؛ وذلك لأنّ الغنيمة إنّما تُأخذ في الحرب التي يكون فيها المقاتل فاتحاً فتكون من نصيبه، ولكن بما أنّكم أسرتموني بالخدعة، ولم تنتصروا عليّ بالقهر والغلبة، فليس في هذه الحرب فتح ولا خسارة، فلا تطلبوني بغنيمة، فعليكم ببيع درعي وسيفي لأداء ديني[626]، ثمّ طلب منهم أن يُخبروا الإمام الحسين× بأن يترك الكوفة ويرجع.
إنّ مسلم بن عقيل× تربّى على يد الإمام الحسين×، ولذا لم يأخذ من الأموال التي هي من سهم الإمام× لسدّ احتياجاته الشخصيّة، وهذا النوع من المعرفة الاعتقادية القائمة على أساس العقل والعدل هو الذي أحيى كربلاء، ولولا هذه القيم والمبادئ لما بقي لكربلاء أثر في قبال الأمواج المتلاطمة من الهجمات الدعائية السيّئة والسياسات المشؤومة والحملات الشرسة.
فمسلم بن عقيل الذي كان في طليعة الشهداء البارزين، ليس من منطقه الغدر والاغتيال، ولذا احتجّ أبو عبد الله الحسين× على الجيش الأُموي، قائلاً: «ويحكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته»[627] فإنّ ابن زياد الجالس على دكّة الحكم في الكوفة، وصار يصدّر الأحكام ضدّ الإمام×، كان قبل أيّام معدودة في بيت هاني، وتحت قبضة سيف مسلم بن عقيل، ومع قدرته على قتل ذلك الملعون[628]، ولكن مسلم (رسولي اليكم) لم يكن من شيمته الغدر والفتك، وعلى هذا الأساس فليس لكم ـ يا بني أُميّة ـ حقّ تطلبوني به، والغرض هو أنّ المجتمع الشيعي يقدّر ويحترم هذه الشهامة التي تطفح بها شخصيّة مسلم بن عقيل.
فمسلم بن عقيل قد قتلوه غدراً، إذ رموه بالحجارة من أعلى السطوح، وشتموه وحملوا عليه بأسيافهم، وضربوه على شفتيه وثناياه الطاهرة، وأراد أن يشرب الماء لشدّة عطشه قبيل شهادته فلم يقدر، وكلّما أراد أن يشرب سال الدم من شفتيه وثناياه في الإناء، وبما أنّ شرب الماء الملوّث بالدم حرام، ردّ إناء الماء ولم يشرب، نعم كان مسلم بن عقيل عطشاناً، ولكنّه رغم ذلك ظلّ يراعي الموازين الشرعيّة إلى أن سقطت ثناياه بالإناء في المحاولة الثالثة[629]. ولكنّه بقي محافظاً على روح الشجاعة والمقاومة حتّى اللحظات الأخيرة، ورفع نفس الشعار الذي كان يرفعه في حال سلامته أمام قاتله، قائلاً: (إنّي أقسمت أن لا أُقتل إلّا حرّاً)، ولمّا كانت دماؤه تسيل على لحيته من رأسه وشفتيه ويده وصدره، وحينما صعد به القاتل إلى سطح دار الإمارة ليضرب عنقه ويرمي به من أعلى القصر، خاطبه مسلم قائلاً: «أيّها العبد»، وهذا يعني أنَّني قمت حرّاً، والآن سأُقتل في سبيل الدين حرّاً، ولكن أنت ـ أيّها القاتل ـ لست سوى عبد حقير وضيع المنزلة ودنيئ المنصب، وهذا الكلام لم يصدر من إنسان عادي؛ لأنّ الإنسان العادي في مثل هذه الحالات لا يقوى على الكلام، ولم يكترث مسلم بتلك الجراحات التي في بدنه، لكنّ الذي أقرح قلب مسلم التهمة التي اتهمه العدو بها، وهي شرب الخمر، ولذا خاطب ابن زياد، قائلاً: إنّك تهذي، وأنا لا أشرب الخمر[630]، وأنا أُقتل حرّاً، وأنت وجلاوزتك عبيد مجرمون.
نعم، فالروح الحرّة النبيلة لا يمكن تقييدها بالسلاسل، وإن قُيّد البدن الماديّ بالسلاسل. ثمّ بكى، فسألوه لِم تبكي؟ أي: أنَّ المقاتل إمّا أنْ يَقتل أو يُقتل، ولكنّه لا يبكي، ولا يئنّ، فقال مسلم: إنّكم ضربتموني وجرحتموني، وما رأيتموني لنفسي بكيت، ولا لها من القتل أرثي، وإنّما أبكي لسيّدي ومولاي الحسين بن علي×؛ لأنّي كتبت كتاباً فيه: أنَّ أهل الكوفة قد بايعونا، وإنّي أنتظر مجيئك، فإذا قرّر الإمام الحسين× ـ اعتماداً على الكتاب ـ أن يتحرّك مع أهله وعياله، وجاء إلى هذه الأرض، ووقع بأيديكم، فبماذا أُجيب ربّي[631].
|
أقسمت
لا أقتل إلّا حراً أنّي رأيت الموت شيئاً نكراً[632]. |
وما حدث لمسلم يدلّ على عظمة وعزّة هذه النهضة، وهذا يعني أنَّ كلّ مَن يلتحق بركب هذه النهضة سيناله نورها، كما قال الله تعالى لنبيّه’: (لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ)[633].
حيث إنَّ الإنسان النوراني لا تصعب عليه الشهادة والشهامة، بل يحسّ بطعمهما ويتلذّذ بهما، فإنّ مسلم في آخر لحظات حياته، قد دعا أهل الكوفة إلى نصرة أبي عبد الله×، وقبل شهادته توجّه نحو مكّة، وسلّم على سيّد الشهداء×[634]، نعم كان يدعو لمولاه الحسين× حتّى آخر لحظات حياته، فإنّ الإنسان بالحسين× سينال شرف الدنيا والآخرة، وهذه الحقيقة واضحة.
ولم يمض وقت حتّى أصبح رأس مسلم بن عقيل بيد قاتله، وأُلقى بجسده من أعلى قصر الإمارة إلى الأرض، وأخذ جلاوزة بني أُميّة يسحبون جسده الطاهر في أزقّة الكوفة.
وكما أنّ مسلم بن عقيل قد ذكر في آخر لحظات حياته الإمام الحسين×، كذلك الإمام الحسين× ذكر مسلماً في لحظات حياته الأخيرة يوم عاشوراء لمّا أخذ ينادي أصحابه، قائلاً: «يا مسلم بن عقيل، ويا هاني بن عروة»[635].
جدير بالذكر: حينما صعدوا بمسلم إلى أعلى دار الإمارة، كان مشغولاً بذكر الله في كلّ خطوة يخطوها، قائلاً: «لا حول ولا قوّة إلّا بالله، بسم الله وبالله وفي سبيل الله»[636].
ثمّ أخبروا الحسين بن علي× بشهادة مسلم، قائلين: إنّه لم يخرجوا من الكوفة حتّى قٌتل مسلم وهاني، وقد شاهدوهما يُجرّان من أرجلهما في السوق، فلمّا سمع الإمام× خبر شهادة مسلم بن عقيل، التفت إلى أبناء مسلم: ليس عليكم منّي ذمام، وحسبكم بمصيبة مسلم فارجعوا، ولكن بما أنَّ بني عقيل كانوا متربّين على يد رسول سيّد الشهداء× مسلم بن عقيل، فقالوا نحن لا نتركك[637].
فالتربية الصالحة للأبناء، ونشر المآثر النبويّة، والأخلاق العلويّة بين أعضاء الأُسرة الواحدة، من أهمّ الأعمال التي كان يحرص أصحاب أبي عبد الله× على القيام بها.
إنَّ من خصال العرب المعروفة إكرامهم الضيف، ولكنّ ابني مسلم قُطع رأساهما في أبشع صورة من قبل القاتل، رغم ما عرضوه عليه من خيارات واقتراحات، ولكنّه لم يهتمّ بذلك، فقالا في آخر لحظات حياتهما: «يا حيّ، يا حكيم، يا أحكم الحاكمين، أُحكم بننا وبينه بالحقّ» وإنّ دعاء المظلوم سريع الاستجابة، فلم يمض وقت طويل حتّى ابتلى الله ـ السريع الحساب ـ قاتلهما بألوان العذاب، وهكذا استشهد إبنا مسلم بـأفجع صورة[638].
الجرعة الخامسة: أحداث كربلاء
المشهور في التاريخ أنّ الحسين بن علي× دخل إلى كربلاء في اليوم الثاني من محرّم[639]، وكان الأئمّة المعصومون^ على علم ودراية بأرض كربلاء، ويولونها اهتماماً خاصّاً، ولذا فإنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب× لمّا مرَّ بأرض كربلاء في حرب صفّين قبل حادثة عاشوراء بعشرين سنة، أخذ قليلاً من تربة كربلاء وشمَّها، وفي بعض الأخبار كان× يُشير إلى مواضع معيّنة في أرض كربلاء، ويقول: (هاهنا هاهنا) فسأله بعض أصحابه عن سبب ذلك؟ فقال: «مصارع عشّاق شهداء»[640] أي: هنا ترقد طائفة من عشّاق الملحمة الإلهيّة بعد ما يذوقوا طعم الشهادة.
لمّا دخل أبو عبد الله الحسين× أرض كربلاء، حطَّ رحاله إلى جانب الفرات، وهو نهر عظيم يجري من شمال شرق كربلاء، ونظراً لغزارة مياه هذا النهر تكوّنت إلى جانبه قرى كثيرة، منها: نينوى وجزء منها الغاضريّة، وضفاف هذا النهر مليئة بالقصب، ولذا عُرف سكّان تلك القرى بصناعة الحصير والبارية، وجاء بخصوص نقل جسد الإمام الحسين× ودفنه التعبير بالبارية أو الحصيرة[641]، وورد كذلك أُشعلت النار يوم عاشوراء في القصب خلف الخيام[642].
وسأل أبو عبد الله الحسين×: ما اسم هذه الأرض، فأجابوه: بأنّ هنا عدّة قرى، منها: نينوى، والغاضريّة، وشاطئ الفرات، وكربلاء، فلمّا سمع الإمام الحسين× اسم (كربلاء) قال كلاماً يشبه كلام أمير المؤمنين× الذي ذكره قبل عشرين سنة: هاهنا مناخ ركابنا، هاهنا مقتل رجالنا، هاهنا مسفك دمائنا، هاهنا مذبح أطفالنا[643].
حينها أمر بنصب خيام الأصحاب والأنصار على الجوانب، ونصب خيام بني هاشم وسطها، وأمر بنصب خيام النساء وسط خيام بني هاشم كي تكون النساء على اتصال بأهلن، وهذا العمل قد حصل في اليوم الثاني من محرّم، وأمّا في ليلة عاشوراء فقد أمرهم بأن يقرّبوا ما بين الخيام، ويضيّقوا من مساحة المخيّم وانتشاره.
وكان ابن زياد قد أمر الحرّ الرياحي أن «يُجعجع بالحسين»[644] وهذا يعني: خذ الحسين× إلى مكان خال من الدعم البشري والطبيعي، وحاول الحرّ بدوره أن يُلجئ الحسين× إلى مكان بعيد عن نهر الفرات، ولم يسمح له بنصب خيامه تحت الظلال، أو إلى جانب الأنهار والأشجار والنخيل، أو بالقرب من تلال أو جبال كي لا يستعين بالعوامل الطبيعيّة، فاضطرّه إلى نصب خيامه في صحراء كربلاء الحارقة بعيداً عن الماء، إضافة إلى منعه عن وصول أيّ عون من الناس لسيّد الشهداء×.
في اليوم السابع من محرّم جاء الأمر بمنع وصول الماء إلى مخيّم الإمام الحسين× [645]، حينما رأى الإمام أنّه لم يبق في المخيّم ماء، ابتعد عن المخيّم عدّة خطوات وحفر بئراً صغيرة، فتدفّق الماء وشربوا، ولمّا علم ابن زياد بذلك، أمر عمر ابن سعد بالتشديد على منع وصول الماء إلى مخيّم الإمام الحسين× [646]، وسدّ جميع المنافذ التي يمكن أن يجلب منها الماء، وكان يهدف من وراء ذلك إلى غايتين: الأولى: عدم تمكّن الحسين× وأصحابه من جلب الماء إلى المخيّم، والثانية: منع أهل القرى المجاورة من إيصال ماء الفرات ـ النهر الذي يقع شمال شرق كربلاءـ إلى مخيّم الإمام الحسين×.
ثمّ إنّ الأطفال أحسّوا بالعطش لقلّة الماء، وآل الأمر إلى تحصيص الماء، نتيجة الأوامر المشدّدة من قبل ابن زياد الملعون، الذي أمر الحرّ بن يزيد الرياحيّ بالتشديد على الحسين×، بقوله: «جعجع بالحسين»[647]، ولم يسمح للمخيّم أن يُنصب إلى جانب جبل أو عين ماء أو في ظلال الأشجار أو بالقرب من الماء، بل أجبره على نصب المخيّم وسط صحراء قاحلة ملتهبة، بعيداً عن نهر الفرات[648].
وممّا يؤلم الإنسان بخصوص عطش الإمام الحسين× وأصحابه في كربلاء، أنّ الشمر الملعون لمّا جاء عصر تاسوعاء بكتاب ابن زياد المشؤوم، الذي قلب الميدان من ساحة حوار إلى ساحة حرب، لم يجد ابن سعد في خيمته، بل وجده يسبح في نهر الفرات[649]. وكما قال محتشم الكاشاني:
وقد بدأت عمليّة تحصيص الماء لقلّته من عصر اليوم السابع من محرّم، حيث أصبحت مهمّة إيصال الماء إلى الأطفال في عهدة قمر بني هاشم[652].
يوم التاسع هو يوم وصول الأمر الأخير من دار الإمارة في الكوفة إلى كربلاء، وكانت الأيّام العشرة الأوائل من شهر محرّم للعام 61 الهجري على الشكل التالي:
اليوم الثاني: دخول سيّد الشهداء× إلى كربلاء[653].
اليوم الثالث: وصول الملعون عمر بن سعد إلى كربلاء.
اليوم الرابع: أرسل فيه عمر بن سعد تقريراً إلى الكوفة، يستعرض فيه أوضاع كربلاء.
اليوم الخامس: وصول أمر خاص من الكوفة إلى كربلاء.
اليوم السادس: إرسال عمر بن سعد كتاباً آخر إلى الكوفة.
اليوم السابع: هو اليوم الذي صدر فيه الأمر بقطع الماء[654].
اليوم الثامن: إرسال كتاب جديد من كربلاء إلى الكوفة.
اليوم التاسع: (تاسوعاء) هو اليوم الذي صدر فيه الأمر من غرفة عمليّات دار الإمارة في الكوفة بحسم موضوع قتال الحسين× ووصل إلى كربلاء[655].
وفي عصر تاسوعاء كان الحسين بن علي بن أبي طالب÷ مستنداً على سيفه أمام الخيام، إذ خفق برأسه على ركبتيه، فشاهد رسول الله| يقول له: «إنّك رائح إلينا عن قريب»[656] وفي هذه الحالة نادته زينب‘، وقالت: يا أخي، أما تسمع الأصوات، وكأنّ القوم يريدون الهجوم على المخيّم. نعم، أرادوا تنفيذ الأمر الأمويّ اللئيم، وتوجّهوا نحو مخيّم الإمام الحسين×، وانتهى الخطب بعد ذلك إلى أخذ مهلة لليلة عاشوراء، لتندلع الحرب في صبيحة اليوم العاشر (عاشوراء).
وعلى قول الإمام الصادق×: «تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين×»[657] إنّ هذه الجملة قالها الإمام الصادق× في الجواب على سؤال: هل يصحّ صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء؟ فأجابهم×: إنّ هذه الأيّام أيّام حزن أهل البيت^، لا أيّام صوم.
عصر اليوم التاسع جاء الشمر بأمان إلى قمر بني هاشم وأخوته من جهة، ومن جهة أخرى جاء بإنهاء الأمر، فإمّا البيعة وإمّا القتال[658].
بما أنّ أُمّ البنين ـ أُمّ قمر بني هاشم ـ تنتمي إلى قبيلة الشمر الملعون، نادى الشمر العباس وأُخوته، قائلاً: «أين بنو أُختنا»[659]، فأراد بنو أميّة بهذه الخدعة والحيلة، أن يصنعوا مع الإمام الحسين× نفس ما صنعوه مع الإمام الحسن× من قبل، لمّا فرّقوا عنه أبرز قادة جيشه، فأرادوا أن يجرّبوا هذه الخديعة مرّة أُخرى مع الحسين بن علي÷؛ لفصل قادته عنه، ولهذا جاؤوا بأمان إلى حامل لواء الإمام الحسين× [660].
فمعاوية بحيله وخدعه السياسيّة استطاع أن يفرّق قادة وحاملي ألوية الإمام الحسن× عنه، حتّى بقي الإمام وحيداً، وأُجبر على الصلح، وهذا ما أراد أعوان يزيد وعمّاله تجربته مرّة أُخرى، حيث أعطوا الأمان لقمر بني هاشم، حامل لواء الحسين×، عسى أن ينتزعوه منه، ويتمكّنوا من سيّد الشهداء×، ويأخذونه ذليلاً إلى ابن زياد، وتُحسم حادثة كربلاء دون دماء.
ولمّا أرادوا عرض الأمان على العباس بن علي× وناداه الشمر، لم يُجب أبو الفضل نداءه، ولم يُعره أدنى اهتمام، ولكنّ الإمام الحسين× قال له: اُنظر ما يقول، فلمّا سمع قمر بني هاشم بكتاب الأمان، قال له: «لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمّننا وابن رسول الله لا أمان له»[661]. فلم تنفع هذه الخطّة، وعزموا في يوم تاسوعاء على إنهاء الأمر، فقال قمر بني هاشم× لأصحابه ـ وكانوا عشرين فارساً ـ : امكثوا حتّى أُخبر الحسين بن علي× بالأمر، وأرى رأيه.
جنود الحكومة الأمويّة القذرة ظنّوا أنّهم سيحسمون الأمر خلال ساعة واحدة، إذ ليس بمقدور سبعين فارساً ونيّف الوقوف بوجه جيش مسلّح، بلغ عدده ثلاثين ألفاً مع عدّته، ولكنّ الليل المظلم لم يكن وقتاً مناسباً للحرب، وعلى أيّ حال فقد بقي حبيب بن مظاهر وزهير بن القين واقفين لينصحا الجيش الأُموي، فقال حبيب بن مظاهر: إنّكم تقاتلون عباد الله المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيراً، فقيل له: لا تزكّي نفسك، فأجاب زهير بن القين ـ أيضاً ـ على مقولتهم[662].
فقال الإمام الحسين× لأبي الفضل العباس: «اركب بنفسي أنت يا أخي... إن استطعت أن تؤخّرهم إلى الغداة وتدفعهم عنّا العشيّة، لعلّنا نصلّي لربّنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أنّي قد أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه والدعاء والاستغفار»[663].
فقال لهم العباس بن علي×: إنّ ابن رسول الله’ يريد منكم أن تمهلوه الليلة (ليلة عاشوراء)، فقبل بعضهم بذلك وأبى آخرون، واختلفوا فيما بينهم، وقال بعضهم: إنّ الوقت يقترب من الغروب، وإذا طلب منكم غير المسلم أن تمهلوه ليلة لقبلتم ذلك، فكيف وهو ابن رسول الله’ ويطلب منكم أن تمهلوه ليلة، فإنّكم قد حاصرتموه من كلّ جانب، وليس لديه طريق للخروج منه، ولا يمكن لأحد أن يلتحق به في كربلاء فينصره، إذن فأمهلوه الليلة، ففعلوا وأجابوه إلى ذلك[664].
فبعد ما جاء الشمر من الكوفة بالكتاب الأخير عصر اليوم التاسع من محرّم، المتضمّن للأمر بالقتال، وعلى أساسه نودي: «يا خيل الله، اركبي وابشري»[665]. قال أبو عبد الله× لأخيه قمر بني هاشم «... فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى الغداة» وليس للإمام× غرض عسكري من تأخير الحرب؛ لأنّ العدو كان على يقين في تلك الظروف من عدم وجود من ينصرهم أو يدعمهم بالسلاح، ولهذا فغرض الإمام× من طلب المهلة ليلة عاشوراء هو الصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، فقال لأخيه العباس×: «فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى الغداة، وتدفعهم عنّا العشيّة لعلّنا... فهو يعلم أنّي كنت قد أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه والدعاء والاستغفار»[666]، فأمهلهم الأعداء تلك الليلة، ولكنّهم قالوا لأهل بيت النبوّة والإمامة ـ بكلّ وقاحة وسوء أدب ـ : إنّ صلاتكم لا تقبل. إنّ الحسين بن علي÷ كان مولعاً بتلاوة آيات القرآن، وحتّى رأسه المقدّس أخذ يتلو القرآن الكريم وهو على القناة وفي الطشت.
وقال الإمام الصادق×: إنّ اليوم التاسع من محرّم «استضعفوا فيه الحسين×»[667] فاليوم التاسع يوم (الاستضعاف) واليوم العاشر يوم (الاستشهاد)، ثمّ قال في الأخير: «بأبي المستضعَف الغريب»[668]. إنّ جميع الأئمّة ـ ومنهم الإمام الحجّة# ـ يفدون الإمام الحسين× بهذه الجملة، حينما يأتي ذكر تاسوعاء وعاشوراء. نحن وآباؤنا فداء لذلك المستضعّف الغريب.
رواية الإمام السجّاد×
قال الإمام السجّاد×: كنت في ليلة عاشوراء مريضاً، فجمع أبي جميع الأصحاب وبني هاشم في الخيمة، وخطب فيهم، وبعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: «فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي» وليس في كربلاء إلّا الموت والشهادة، وإنّ هؤلاء القوم يطلبونني «وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً» وهذا يعني كما أنّ الجمل وسيلة جيّدة للسفر كذلك الليل، فاستفيدوا من سواد الليل واتركوني أنا وأهلي في هذه الديار[669].
وقد ورد في خطبة سيّد الشهداء×: «أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السرّاء والضرّاء، اللهم إنّي أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوّة، وعلّمتنا القرآن، وفقّهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة، فاجعلنا من الشاكرين، أمّا بعد: فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي خيراً، ألا وإنّي لأظنّ أنّه آخر يوم لنا من هؤلاء، ألا وإنّي قد أذنت لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ، ليس عليكم منّي ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً»[670].
وقال الإمام السجّاد×: وكان أوّل مَن بدأ بالكلام بعد ما أرخصهم، الإمام× العباس بن علي (رضوان الله عليه) قائلاً: «لِم نفعل ذلك؟! لنبقى بعدك؟! لا أرانا الله ذلك أبداً...، واتبعته الجماعة عليه، فتكلّموا بمثله ونحوه»[671]، وقد أبلغهم الإمام الحسين× بأنّ الجميع يُقتل حتّى الرضيع، فسأل القاسم عمّه×، فقال: «يا عم، ويصلون إلى النساء حتّى يُقتل عبد الله وهو رضيع؟» فقال: [لا يصلون إلى الخيام ما دمت حيّاً] «فداك عمّك، يُقتل عبد الله إذا جفّت روحي عطشاً»[672] فأطلبُ له الماء فلا يسقونه، فيصيبونه بسهم ذي ثلاث شعب فيستشهد، «فقال له القاسم بن الحسن: وأنا فيمن يُقتل؟ فأشفق عليه، فقال له: يا بنيّ، كيف الموت عندك؟ قال: يا عم، أحلى من العسل، فقال: إي والله، فداك عمّك، إنّك لأحد مَن يُقتل من الرجال معي، بعد أن تبلو ببلاء عظيم»[673].
ولمَّا بشّر الإمام الحسين× جميع أصحابه بالشهادة، كان حبيب بن مظاهر الأسدي ـ وهو من كبار أصحاب الحسين× ـ واقفاً، فسأل: هل سيقتلون غداً ابنك علي؟ ويقصد (الإمام زين العابدين)، فقال الإمام السجّاد×: وكنت مريضاً آنذاك، وواقفاً بباب الخيمة، فأشار الإمام الحسين× إليَّ قائلاً: «ما كان الله ليقطع نسلي من الدنيا، فكيف يصلون إليه وهو أب ثمانية أئمّة^»[674].
ولمّا سمع الإمام السجّاد× نداء الحسين× يوم عاشوراء (هل من ناصر ينصرني) نهض السجّاد× يتوكّأ على عصا، وعندها نادى أبو عبد الله× أخته زينب: أحبسيه؛ «لئلّا ينقطع نسل رسول الله»[675].
محاورة سيّد الشهداء× مع زينب الكبرى‘
في ليلة عاشوراء، بعد ما حثّ الإمام الحسين× ـ لآخر مرّة ـ أصحابه على الانصراف، ووجد أنّهم عازمون على البقاء معه، توجّه إلى خيمة أُخته زينب الكبرى‘، فسألت أخاها الحسين×: هل أنت على ثقة من أصحابك كي لا يتركوك غداً وحيداً؟ والسبب في طرح هذه السؤال من قبل السيّدة زينب‘ إنّما يعود لأنّها أوّلاً: رأت خيانة الجيش للإمام الحسن× بشكل كامل، وثانياً: بسبب كثرة الجيش المعادي، حتّى قيل: إنّ عددهم يصل إلى ثلاثين ألف مقاتل[676]، مع أنّ أصحاب الإمام الحسين× قليلون جدّاً، لا يتجاوزون (المائة مقاتل) وشهادتهم أكيدة، فإذا فرَّ بعضهم غداً عند اللقاء دبّ الوهن والضعف. فأجابها الإمام الحسين×: «والله، لقد بلوتهم، فما وجدت فيهم إلّا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطفل إلى محالب أُمّه»[677]، فلمّا سمعت زينب‘ بهذا الكلام هدأت.
إنّ هذه المحاورة قد سمعها أحد أصحاب الإمام حينما كان يحرس خلف الخيام، وبما أنّ الأنصار لا يوصلون كلامهم مباشرة إلى أبي عبد الله× وقمر بني هاشم، وإنّما عن طريق مسلم بن عوسجة أو حبيب بن مظاهر والشيوخ منهم؛ لذا جاء ذلك الصحابي إلى حبيب بن مظاهر، وأخبره بما سمع، ولأجل أن يطمأنّ أهل البيت^ من إخلاص وصمود الأصحاب، جاء حبيب بن مظاهر الأسدي إلى خيام الأنصار وناداهم ـ ويحتمل أنّهم قد سمعوا المحاورة بأنفسهم ـ فخرجوا وخرج بنو هاشم أيضاً، فطلب حبيب من بني هاشم الرجوع إلى خيامهم، واجتمع بالأصحاب، وأخبرهم بقلق ومخاوف السيّدة زينب الكبرى‘، ثمّ طلب حبيب من الأصحاب الحضور عند الإمام الحسين× لتجديد العهد به، فحضر جميع الأصحاب وسلّموا، ثمّ قالوا: «يا معشر حرائر رسول الله، هذه صوارم فتيانكم... وهذه أسنّة غلمانكم»[678]لو أعطانا سيّدنا الرخصة في القتال لحملنا عليهم هذه الليلة، فلم تخرج السيّدة زينب‘ من الخيمة، وإنّما شكرتهم من داخل الخيمة، ودعت لهم.
فقال لها الإمام الحسين×: إنَّ أصحابي «يستأنسون بالمنيّة دوني استئناس الطفل إلى محالب أُمّه»[679].
وبعد هذا الحوار جعل سيّد الشهداء× يوصي أصحابه الأوفياء فيما يخصّ الخيام وأنفسهم ـ وقد تقدّم أكثر ذلك ـ ثمّ أمرهم أن يربطوا حبال الخيام بعضها ببعض، وأن يحفروا خندقاً حول المخيّم ما عدا الواجهة، ويملؤوا ذلك الخندق بالقصب المأخوذ من ساحل الفرات كي يتمّ صدّ هجوم العدو على حرم أهل البيت^ من خلال إشعاله، وهذا ما قد فعلوه ليلة عاشوراء، ولم يبق منفذ للعدو إلّا واجهة المخيّم، ولا يمكن للعدو أن يهجم على المخيّم من الخلف[680].
ثمّ أوصاهم ليلة عاشوراء بالاغتسال وتطهير الثياب كي يكونوا عند الشهادة بلباس نظيف طاهر؛ فإنّ ثيابهم أكفانهم «واغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم»[681]، ومن المناسب أن يكون للشهيد كفن مُشَرِّف، ثمّ انصرف كلّ واحد من الأصحاب إلى خيمته، وقد انشغلوا في تلك الليلة بالصلاة وتلاوة القرآن والمناجاة والدعاء والاستغفار، بحيث وصفوهم: «لهم دويّ كدويّ النحل»[682].
لمَّا أصبح الصباح يوم عاشوراء، صلّى الحسين× بأصحابه صلاة الصبح، وبينما كان واقفاً أمام الخيمة، أُطلق أوّل سهم من العدو نحو مخيّم الحسين×، وكان بيد عمر بن سعد الملعون؛ ليكون أوّل مَن رمى نحو مخيّم الحسين× كي يحصل على جائزة من أميره، ثمّ تلته السهام كالمطر «أقبلت السهام من القوم كأنّها القطر»[683]، ولعلّ جماعة من الأنصار قد نالوا الشهادة في بداية اليوم العاشر بسبب كثرتها.
ثمّ حدّد مَن يقف على ميمنة الجيش وميسرته، فجعل حبيب بن مظاهر على الميمنة، وزهير بن القين على الميسرة، وأعطى الراية أخاه العباس، وثبت هو في قلب الجيش[684]، ثمّ بدأت الحرب، فتقدّم الأنصار نحو الميدان، ونالوا الشهادة واحداً تلو الآخر، وهم يرتجزون بالتوحيد والنبوّة والإمامة والعدالة والجهاد.
وفي الظهر ذكر أحد أصحاب أبي عبد الله الحسين× الصلاة، فقال: حان وقت الصلاة، فدعا الإمام× له بالخير، قائلاً: «جعلك الله من المصلّين»[685] فوقف الإمام ظهر يوم عاشوراء للصلاة، وقال: «سلوهم أن يكفّوا عنّا حتّى نصلّى» وبالرغم من أنّ صلاة الإمام× وأصحابه كانت صلاة الخوف وهي قصيرة جدّاً لكنَّ المعاندين أبو أن يمهلوه وامتنعوا من تلبية طلبه [686].
شهادة حبيب بن مظاهر
بحسب بعض الأخبار أنّ حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة الشيخين الطيّبين، قد خرجا من الكوفة للالتحاق بركب الحسين×؛ ليضحّيا بنفسيهما بين يديه، ورغم أنَّ الطريق مغلقة من طرف واحد (أي: الدخول إلى كربلاء ممنوع والخروج منها متاح)، استطاعا الوصول إلى الإمام الحسين×، متجاوزين المخاطر والعقبات.
بناء على رواية، برز أحد هذين الشيخين الكبيرين إلى الميدان قبل الآخر، ولمّا سقط وقف الآخر عنده، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، قائلاً له: خرجنا معاً من الكوفة إلى كربلاء، وها أنت تفارقني، وإنَّي بالأثر، ولو أنّي كنت أبقى لأحببت أنْ توصيني بما يهمّك، فقال: «أوصيك بهذا»[687]، وأشار إلى الإمام الحسين×. وقد وقف الإمام الحسين× على مصرع هذين الشيخين البصيرين الطيّبين الوفيين[688].
وها هو قبر حبيب بن مظاهر عند باب حرم سيّد الشهداء×، ويمرّ به زوّار الإمام الحسين× عند دخولهم وخروجهم.
الحرّ من كبار الشهداء في كربلاء، ولكنّ شهداء كربلاء ليسوا بمنزلة واحدة، ولذا قال الإمام السجّاد× بحقّ عمّه العباس بن علي×: «إنَّ للعباس عند الله منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة»[689].
لمّا صدر الأمر بفصل الرؤوس عن أجساد الشهداء في كربلاء، حملت قبيلة الحرّ جثمانه الطاهر من بين مصارع الشهداء كي لا يُقطع رأس كبير قبيلتهم[690]، وبالرغم من أنّه حظي بحسن العاقبة، إلّا أنّه بمقدار إيذائه قلوب أولاد أبي عبد الله الحسين×، كان ابتعاده عن الأرض التي طيّبتها أجساد شهداء كربلاء، فدُفن في مكان آخر، كما لم يكن رأسه في مصاف رؤوس الشهداء.
كان سيّد الشهداء× يتعامل مع أصحابه الشهداء بلطف وعطف وصفاء، باعتباره الإمام المعصوم الذي له الولاية على الجميع، ولمّا سمع نداء الحرّ بن يزيد الرياحيّ واستغاثته، وقف على مصرعه، وهدّأ من روعه، ووضع رأسه في حجره[691]، وشدّ وشاحاً مباركاً على رأسه[692].
كان سعيد بن عبد الله الحنفي من خلّص أصحاب سيّد الشهداء×، ولمّا أراد الإمام× أن يصلّي ظهر يوم عاشوراء، قال هو وصحابي آخر للإمام×: ما دام الأُمويّون ـ حاليّاً ـ لا يمهلونا، فأنت صلّ، ونحن نقف أمامك نتلقّى سهامهم بصدورنا[693]، ولم يكن هذا مطلبه لوحده، بل طلبه جماعة من الأصحاب أيضاً، فاستفهم سعيد بن عبد الله من الإمام الحسين×: بأنّه سيحظى بهذا الشرف؟ والسرّ وراء هذا السؤال، أنّه قد التحق بكربلاء على الرغم ممّا عاناه في سبيل ذلك، فتحمّل مشاقّ السفر، حيث قطع ألفاً ومئتي فرسخ؛ لكي يحظى بشرف الحضور بكربلاء، ويراق دمه على أرضها؛ إذ إنّ سعيد بن عبد الله الحنفي كان الممثّل الرسمي لأهل الكوفة، وقد جاء منها إلى مكّة ليوصل كتب أهلها إلى أبي عبد الله الحسين×، والمسافة من الكوفة إلى مكّة ثلاثمائة فرسخ، ومن الصعب جدّاً قطع هذه المسافة في ذلك الوقت[694]، ثمّ رجع مع مسلم بن عقيل من مكّة إلى الكوفة، وفي المرّة الثالثة ذهب من الكوفة إلى مكّة بعد شهادة مسلم بن عقيل، ثمّ رجع في المرّة الرابعة مع سيّد الشهداء× من مكّة إلى الكوفة، وحطّ رحله في كربلاء.
أذن أبو عبد الله الحسين× لسعيد بالوقوف بين يدي الإمام× وأصحابه، وصار يقي السهام من كلّ جانب، تارة يتلقّاها بيده، وأخرى برجله، وأحياناً بصدره، وفي هذه اللحظات القصيرة التي أُدّيت فيها صلاة الخوف ـ لأنّ هيئة هذه الصلاة في الشريعة الإسلامية بهذا النحو ـ أُصيب سعيد بن عبد الله الحنفي باثني عشر سهماً، وفي اللحظات الأخيرة من الصلاة جاء سهم نحو الإمام×، فتلقّاه سعيد بن عبدالله بوجهه[695]، فالتفت إلى الحسين×، قائلاً: «أَوفيت يا بن رسول الله؟ قال: نعم، وأنت أمامي في الجنّة»[696].
أنس الكاهلي هو الآخر من أصحاب الحسين×، والذي كان شيخاً طاعناً في السنّ، ومن أصحاب رسول الله’ المعروفين، وقد طلب الإذن في أن يبرز إلى الميدان، فقال له الحسين×: ولكنّك شيخ كبير، فقال: إنّي لا أتقدّم للمعركة لأَقتل الأعداء، وإنّما أتقدّم حتّى أُقتل. فهذا الصحابي قلّ نظيره في العراق والحجاز والشام؛ لأنَّه قد رأى رسول الله’ وسمع كلامه، وبما أنَّ حادثة كربلاء وقعت سنة إحدى وستّين للهجرة، وهذا يعني أنّها حصلت بعد رحلة رسول الله| بخمسين سنة، وهو ممّن أدرك رسول الله’ في الخمسينيّات من عمره، فيكون في واقعة كربلاء قد بلغ المائة سنة، فإذا ما قُتل في كربلاء، فستظلّ الأجيال تذكر أنَّ شيخاً من أصحاب رسول الله| نال الشهادة في ركاب ابن بنت رسول الله’، وكيفما كان، فقد أذن أبو عبدالله× لأنس، وطبقاً لما روي أنّه محدودب الظهر، وقد تدلّا حاجباه على عينيه، فطلب قطعتين من القماش، شدّ إحداهما على وسطه، والثانية على رأسه، رافعاً بها حاجبيه[697] كي يرى الناس ويرونه.
برز في كربلاء من بين أصحاب سيّد الشهداء×، غلام أسود اسمه جون، وعندما استُشهد وقف الإمام الحسين× على مصرعه، ولم يتوقّع جون أنّ مولاه الحسين× يقف على مصرعه، ليس هذا وحسب، بل صنع معه نفس ما صنعه مع علي الأكبر×، حيث أنّه× لمَّا سمع صوت واستغاثة علي الأكبر أقبل إليه مبادراً، ووضع خدّه على خدّه وقبّله[698]، وهكذا وضع خدّه على خدّ ذلك الغلام.
يكسان رخ غلام وپسر بوسه داد وگفت-در دین ما سیه نکند فرق با سفید[699]
وما أعظمه من فخر يناله الشهيد حينما يقف على مصرعه إمام عصره، ويدعو له بأن يُبيّض الله وجهه، ويُطيّب ريحه، ويحشره مع محمد وآل محمد[700]، عند ذلك تُصبح الشهادة ألذّ من الشهد.
شهادة علي الأكبر×
إنّ الوفاء والصدق والشجاعة صفات تطفح في حادثة عاشوراء، فالعدو كان يحاول حلّ القضيّة مع أبي عبد الله× بالتفاوض، حيث طلبوا منه التنازل والبيعة، ولكن بلا جدوى، ثمّ جرّبوا مع قمر بني هاشم بمنحه الأمان كي يسلّم، ولكن لم ينفع[701]. بعدها توجّهوا نحو علي بن الحسين×، وأعطوه الأمان ـ أيضاً ـ ولكن دون جدوى.
ذلك أنَّ أُمّ علي الأكبر وأُمّ قمر بني هاشم تنتسبان إلى قبائل قد حضرت في جيش عمر بن سعد، ولشدّة الاهتمام بالأصول القبليّة في الحجاز، صارت بعض تلك القبائل تطلب الأمان لمن ينتمي إليها ممن حضر في معسكر أبي الأحرار.
وقد ردّ علي الأكبر على الأمان مرتجزاً:
|
أنا علي بن الحسين بن علي |
ومعنى هذا الكلام أنّ عليّاً يُقسم بالكعبة المكرّمة بأنّه وأباه وأهل بيته أولى الناس بالنبي الأكرم’؛ لأنّ نسبه متّصل بالنبوّة والإمامة والرسالة والشريعة الإسلاميّة، وأمّا الشمر وعمر بن سعد وابن زياد فنسبهم دنيء، بعيد كلّ البعد عن مثل هذا النسب الشريف، فلا أقبل أمانهم أبداً.
علي الأكبر× كان مولعاً بالشهادة، ولمّا استرجع[703] سيّد الشهداء× في طريقه بين مكّة وكربلاء، سأله علي الأكبر عن سبب استرجاعه، فقال الإمام×: «يا بني، إنّي خفقت خفقة، فعن لي فارس على فرس، وهو يقول: القوم يسيرون، والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنّها أنفسنا نُعيت إلينا...، فقال له: يا أبت، لا أراك الله سوء، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد، قال: فإنّنا إذاً لا نبالي أن نموت محقّين»[704]، وهذا الكلام مقتبس من كلام أمير المؤمنين×، حيث قال: «وَالله ما أُبالِي دَخلْت إِلى الْمَوْت أَو خرج الْمَوْتُ إِلَيَّ»[705].
كان عليّ× أوّل شهيد من بني هاشم، ويدلّ عليه ما ورد في الزيارة الناحية للإمام صاحب العصر×: «السلام عليك يا أوّل قتيل من نسل خير سليل»[706].
عند ما طلب علي الأكبر× الرخصة من أبيه ليبرز إلى الميدان، وأذن له، قبض الإمام الحسين× على شيبته الكريمة، وقال: «اللهمّ اشهد، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك»[707]، وهذا يعني: يا إلهي، إنّ أفضل ولدي سينال شرف وكرامة التضحية في سبيلك، وإنّي أشكرك ـ يا ربّ ـ على تضحية وفداء هذا الغلام، وحينئذ فإنّ حفظ الدين على عهدتك. وهذا الموقف يكشف عن العاطفة العقلانيّة لسيّد الشهداء×. نعم، فإنّ الإمام المعصوم× يتمتّع بعاطفة عقليّة لا إحساسيّة.
ثمّ إنَّ الإمام× أذن له، وألبسه لامة الحرب، وتوجّه نحو القوم، وهو يرتجز:
|
أنا علي بن الحسين بن علي |
ومعنى هذا الكلام أنّني أُدافع عن ديني وأبي باعتباره إمامي، وأُقسم بالله لا يحكم فينا من هو رجس غير شريف، وهذا هو شعار الإمام الحسين×: «ألا وإنّ الدعيّ ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلّة والذلّة وهيهات من الذلّة»[709].
ورجع علي بن الحسين من ميدان الحرب، وقال لأبيه: «يا أبه، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من ماء سبيل، أتقوّى بها على الأعداء»[710]. نعم، لم يطلب علي الأكبر الماء لكي يروي عطشه ويتلذّذ بالماء، وإنّما طلبه لأجل أن يتقوّى به على قتال معاندي العقل والعدل، فقال له الإمام×: «يا بنيّ، هات لسانك»[711]. فلمّا وضع علي الأكبر لسانه في فم أبيه وجده جافّاً، انتابه شعور بالقلق، ولعلّه قال في نفسه: (ليتني قُتلتُ عطشاناً ولم أطلب من أبي شيئاً لايقدر على نيله). بعدها سعى لإزالة الغمّ الذي غمر قلب سيّد الشهداء×، محاولاً جبر قلبه المكسور.
ثمّ برز علي الأكبر× مرّة ثانية إلى الميدان، وسطّر أروع صور القتال، وأثناء انشغاله بالقتال فاجأه أحدهم بالسيف على رأسه؛ ففقد زمام فرسه، وأخذه الفرس وسط العسكر، وكلّما مرّ على أحدهم ضربه بالسيف، ولذا قالوا بشأن مقتل علي الأكبر: «فقطّعوه بسيوفهم إرباً إرباً»[712].
فسمع الإمام× صوت ولده علي الأكبر، وهو ينادي: «يا أبتاه، عليك السلام، هذا جدّي رسول الله يقرئك السلام، ويقول: عجّل القدوم إلينا»[713]. في اللحظات الأخيرة من عمر الإنسان ما يعود يرى الدنيا، وإنّما تفتح عيناه على عالم البرزخ والملكوت، وعلي الأكبر لمّا نادى والده الحسين× كان قد شاهد جدّه رسول الله’، وسقاه شربة من الماء «يا أبتاه، هذا جدّي رسول الله’، قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً»، ومعنى الكلام أنِّي طلبت منك الماء لأتقوّى به على نصرتك، وتألمّت أنتَ؛ لأنّه لم يكن مقدوراً لك، الآن قد سقاني جدّي بكأسه وأرتفع ظمأي، ثمّ قال النبي الأكرم’ في هذه الحالة لعلي الأكبر: أخبر ولدي بأن يُعجّل القدوم، فقال علي الأكبر: «هو يقول لك: العجل العجل، فإنّ لك كأساً مذخورة»[714].
ولمّا سمع سيّد الشهداء× نداء واستغاثة ولده، أقبل كالليث نحوه، رآه مقطّعاً إرباً إرباً «ووضع خدّه على خدّه»[715]. وبما أنّ مقدار تألّم الإنسان وتفجّعه على قدر عظمة القتيل، فكيف سيكون تفجّع الإمام الحسين× وتألمّه على مصاب أشبه الناس برسول الله’! صار ينعاه بقوله: «أمّا أَنت فقد استرَحْتَ مِن هَمِّ الدنيا وغمِّها وشدائِدها، وصِرتَ إِلى رَوْح وَرَيْحان، وقَد بَقِي أَبوك فريداً وحيداً»[716].
أبطأ الإمام الحسين× عند ولده، فتقدّمت عقيلة بني هاشم السيّدة زينب الكبرى‘ عدّة خطوات من المخيّم نحو الميدان؛ لتشارك أخاها في هذا العزاء والمصيبة، ولغرض صرف توجّه الإمام الحسين× عمّا جرى على ولده وشدّة مصيبته به، وهي «تنادى: يا أُخيّاه، ويا بن أخاه» فبالرغم من شدّة علاقة الإمام الحسين× بولده علي الأكبر، لمّا سمع نداء السيّدة زينب‘ قام من جثمان علي الأكبر؛ رغبة بالحفاظ على حرمة أُخته زينب‘ «فجاءها الحسين، فأخذ بيدها فردّها إلى الفسطاط»[717]، ومعنى هذا الكلام: يا أُختاه، إنّي علمتُ بما يدور في قلبكِ، وعرفتُ لأيّ شيء جئتي إلى الميدان، فارجعي إلى الخيمة، فإنّي سوف لن أبقى إلى جانب هذا الجثمان، ولا أحمله، فالإمام× احتراماً للسيّدة زينب‘ وعاطفتها الطاهرة لم يحمل علي الأكبر إلى خيمة دار الحرب بنفسه، وإنّما أمر بني هاشم أنْ يحملوه، قائلاً: «احملوا أخاكم، فحملوه من مصرعه حتّى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يُقاتلون أمامه»[718].
نعم، بالرغم من أنّ أكثر أجساد الشهداء كان الإمام× يحملها بمساعدة الآخرين إلى المخيّم، لكنّه× أوكل حمل جسد علي الأكبر إلى بني هاشم، ولعلّ ما صنعه مراعاة لعواطف السيّدة زينب‘.
ولما ودّع الإمام× علي الأكبر تلا هذه الآيات: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[719] أي: إنّنا من سلالة إبراهيم، ونحن على نهج نوح وإبراهيم وموسى وعيسى^.
ثمّ قال سيّد الشهداء× لعمر بن سعد: «قطع الله رحمك كما قطعت رحمي...، وسلّط عليك من يذبحك على فراشك»[720]، وقد استجاب الله دعاءه، وما أسؤها من عاقبة ادُّخرت لابن سعد الذي قُتل على فراشه.
لا يصحّ القتال بين يدي الإمام المعصوم× إلّا بإذنه، ولم يبخل بنو هاشم بالإيثار والتضحية بالنفس، فكانوا يستقبلون الموت، وبما أنّ أخذ الرخصة من الإمام× أمر ضروري، تقدّم القاسم بن الحسن لأخذها، فلم يُعطه الإمام× الإذن بالقتال، إلّا أنّه تمكّن بإصراره من أخذ الرخصة. ولمّا سمع سيّد الشهداء× نداء واستغاثة القاسم بن الإمام الحسن المجتبى× أقبل إليه يقول: «عزَّ ـ والله ـ على عمّك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك»[721]. ولم يترك جثمانه الطاهر وسط الميدان، وحمله ـ بحسب ما روي ـ إلى الخيام[722].
لمّا رجع فرس سيّد الشهداء× خالياً يوم عاشوراء، بعد أن اجتاز تلك الأحداث ورجع من الميدان، خرج عبد الله بن الحسن، وهو الأخ الأصغر للقاسم ابن الحسن×، فوصل إلى عمّه الحسين×، ولمّا كان لا يتمكّن من الدفاع عن عمّه الحسين× احتضنه فقط، وفي تلك الأثناء أهوى أحد الظالمين بالسيف على أبي عبد الله×، فاتّقاها عبد الله بيده فأطنّها بالسيف، فإذا هي معلّقة، فضمّ أبو عبد الله× الغلام إلى صدره، وقال له: «يا بن أخي، اصبر على ما نزل بك، واحتسب في ذلك الخير، فإنّ الله يُلحقك بآبائك الصالحين»[723].
طلب العباس× يوم عاشوراء الإذن في أن يجلب الماء إلى الأطفال، وحتّى يحصل على الماء لا بدّ أن يمرّ وسط السهام والسيوف والرماح، وليس هذا بالعمل السهل اليسير. حقّاً، إنّ قتال الجنود الموكّلين بمشرعة الفرات أمر صعب وخطير[724].
حمل أبو الفضل العباس على الجنود، وكشفهم عن المشرعة، نزل ومدّ يده في الماء، فأحسَّ ببرده، ولكنّه لم يشرب منه حينما «ذكر عطش الحسين×»[725]، طبعاً هو ما انفك عن ذكر عطش أخيه الحسين× دائماً وفي كلّ وقت، فليست الفضيلة هنا لتذكّره عطش الحسين×، وإنَّما لمواساته وإيثاره، ولو أنّه شرب الماء لا يعني عدم وفائه لإمامه×، لكنّه أراد أن يقتدي بإمامه العطشان، ويبقى عطشاناً مثله ومثل أهل بيته، ويحظى بفضيلة المواساة ليضيفها إلى كمالاته، إذ مثل هذه الفضائل لا تصدر إلى من الناس الكمّل.
نعم، إنَّ عدم شرب العباس بن علي× للماء له جذور في خلقه، حيث تلقّى تربيته الزاكية في مدرسة أمير المؤمنين علي×، الذي كان يأكل خبز الشعير، ويلبس الثياب البسيطة، مواساة لمن بالحجاز واليمامة[726].
وعلى كلّ حال، كان على مشرعة الفرات خمسمائة جندي مسلّح، ولم تكن مهمّتهم مجرّد المنع عن الماء، بل واحدة من مهامّهم الأخرى منع عبور أهل القرى والتحاقهم بجيش الإمام الحسين×.
إنّ قمر بني هاشم والإمام الحسين× هم قادة هذا الركب، ولذا دخل قمر بني هاشم إلى الشريعة عطشاناً، وخرج منها عطشاناً[727]، ولا بدّ أن يضحّي بنفسه عطشاناً، لأنّه ساقي عطاشى الحرم.
حدس العباس بن علي بأنّ الأعداء لن يسمحوا له بإيصال ماء الفرات إلى الأطفال العطاشى ـ أبداً ـ مع علمه بحال الأطفال الذين يترقّبون عودته ومعه الماء، عندها قال في نفسه: كيف لي أن أشرب الماء وأطفال الحسين عطاشى!
فالأطفال وعيالات الحسين× كانوا على علم بأنَّ أبا الفضل لا يشرب الماء وهم عطاشى، وهذا في الحقيقة بذاته درس من دروس النهضة الحسينية[728]، نعم، إنَّ نهضة كربلاء صاحبة الفضل في تكامل البشريّة وتعليمها الوفاء والحرّية، حيث إنّها دعت المجتمعات إلى الوصول لمقام الإنسانيّة وعلّمتها معنى الإنسانيّة.
إنَّ العباس بن علي بعد أن ملأ القربة ماءً، لا بدّ أن يمرّ من تحت سيوف الأعداء ورماحهم وسهامهم، ليتمكّن من إيصال الماء إلى مخيّم الإمام الحسين×، وبناء على ما نقله المؤرّخون لم يتمكّن أحد من مواجهة قمر بني هاشم، ولذا كَمَن له أحدهم، فلمّا مرّ به قطع يده اليمنى، فأخذ اللواء بيده اليسرى، ثمّ تقدّم أكثر، وإذا بآخر حمل عليه فقطع يده اليسرى[729]، فاستعان بصدره وما تبقّى من يده اليمنى واليسرى على حمل اللواء، وهذا نظير ما حصل لأمير المؤمنين× في الحروب التي خاضها في صدر الإسلام، حيث ورد في التاريخ: «كسرت زند علي يوم أحد، وفي يده لواء رسول الله’، فسقط اللواء من يده، فتحاماه المسلمون أن يأخذوه. فقال رسول الله: فضعوه في يده الشمال، فإنّه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة»[730]، لأنّ رسول الله’ يرى أنَّ حمل اللواء بيد أمير المؤمنين اليسرى أفضل من غيره، هذا من جانب، ومن جانب آخر ينبغي أن يحمل اللواء رجل يحافظ على عزّة الإسلام حتّى الشهادة.
نعم، فقمر بني هاشم بعد ما قطعت يداه: «ضمّ اللواء إلى صدره»[731]، وأخذ القربة بأسنانه[732]، وقد ورد في قصيدة منسوبة لأمّ البنين، جاء فيها:
|
يا من رأى العباس كر |
ونقل ـ أيضاً ـ أنّه قد أصاب القربة سهم فأُريق ماؤها، وأصبح أبو الفضل متحيّراً، فلا ماء يوصله إلى المخيّم، ولا يدين فيقاتل بهما الأعداء ويجلب بهما الماء مرّة أخرى.
أصاب سهم عين أبي الفضل العباس، وضُرب بالعمود على رأسه، عندها سقط من على جواده، لأنّه ما عاد قادراً على الركوب. دائماً ما كان أبو الفضل ينادي أخاه الحسين× يا سيّدي يا مولاي...، ولم يناده إلى تلك اللحظات (يا أخاه) إلّا أنّه حينما قدّم كلّ شيء في سبيل الله، ناداه «يا أخي، أدرك أخاك» عسى أن يُسرع إليه الإمام ويقف عند رأسه، فكلّ إنسان عند الموت يحتاج إلى أن يحضر عنده إمام زمانه×، إذ إنّ الموت أمر صعب جدّاً، وأراد العباس أن يقضي لحظاته الأخيرة إلى جانب إمامه.
ولمّا حضر سيّد الشهداء× عند مصرع أخيه أبي الفضل العباس، قال: «الآن انكسر ظهري، وقلّت حيلتي»[734].
|
فاليوم نامت أعين بك لم
تنم |
لم يكن جثمان أبي الفضل العباس قابلاً لأن يُنقل إلى المخيّم، وقد جرى التقدير الإلهي أن يبقى جسده الطاهر منفرداً، وحينما حضر السجاد عند دفن أجساد الشهداء حيث وارى أجسادهم جميعا في الحائر فيما يلي رجلي الإمام الحسين×، أمر بني أسد بعدم نقل جثمان أبي الفضل العباس من موضعه الذي قتل فيه، وأن يحفروا له فيه قبراً منفرداً، وهذا هو السر في انشاء (السَّقَّايات) إلى جوار الحسينيّات، وهذا مَعْلَم من كربلاء.
وقد طلب الإمام السجّاد× المساعدة من بني أسد في دفن الشهداء إلّا في شهيدين تولّى دفهنما بنفسه، ولم يطلب منهم المساعدة، الأوّل: سيّد الشهداء الحسين بن علي÷، حيث تولّى مواراة الجسد الطاهر بنفسه[735]، والثاني: قمر بني هاشم×، وقال لهم «إنَّ معي من يعينني»[736] ومراده من هذا الكلام أنّ معه الملائكة تعينه على دفن سيّد الشهداء× وأبي الفضل العباس×.
وأنّ جثمان العباس× وإن كان لا يمكن نقله إلى المخيّم؛ لأنّ جسده كان مقطّعاً إرباً إرباً، لكن هذا لم يكن السبب الوحيد في عدم حمله إلى المخيّم، وتركه على الشريعة، ولعلّ ما كان يهدف إليه سيّد الشهداء× والإمام السجّاد× أن يكون لقمر بني هاشم مزاراً مستقلاً.
إنَّ أبا الفضل العباس الذي تعلّم التضحية والإخلاص والتفاني بالعمل في ظلّ التربية التي تلقّاها على يد علي بن أبي طالب×، ظهرت له فضائل ومناقب كثيرة، نشير إلى جانب منها:
1ـ باب الحوائج: للإنسان القدرة أن يصل إلى مرتبة ومقام يصبح فيه أحد قنوات الفيض الإلهي ومجاريها؛ فإنّ مبدأ الفيض هو الله فقط الذي لا شريك له ولا نظير.
2ـ السقّاء: وتعني السقاية وإيصال الماء إلى خيام سيّد الشهداء×.
3ـ حامل اللواء: إنّ اللواء الرسمي في ثورة سيّد الشهداء× كان بيد أبي الفضل العباس×، كما أنّ اللواء الرسمي لنهضة النبي الأكرم’ في صدر الإسلام كان بيد علي×.
لمّا طلب أبو الفضل العباس× من سيّد الشهداء× الإذن في الخروج إلى الميدان، قال له الإمام: «إذا مضيت تفرّق عسكري» وبما أنّ العباس كان حامل لواء الجيش فإذا قُتل سينهار نظام الجيش، ولذا لم يعطه الرخصة قبل الآخرين، وتفرّق العسكر لا يعني الهروب؛ لأنّه لا يروم أحد الهروب في ذلك اليوم.
وحمل الراية كان منذ بداية تحرّك الركب الحسيني من المدينة، فقد ورد: «حَمَلَ الراية أمام الإمام»[737]، وما نقله جدّ عبد الله بن سنان حول انطلاقة ركب الإمام الحسين× من المدينة، كان كالتالي:
«عن عبد الله بن سنان ـ الذي تعدّ رواياته صحيحة ومعتبرة ـ عن أبيه، عن جدّه أنّه قال: خرجت بكتاب من أهل الكوفة إلى الحسين×، وهو يومئذ بالمدينة، فأتيته فقرأه، فعرف معناه، فقال: أَنْظِرْني إِلى ثَلاثة أَيّام، فبقيت في المدينة، ثمّ تبعته إلى أن صار عزمه بالتوجّه إلى العراق، فقلت في نفسي أمضي وأنظر إلى ملك الحجاز كيف يركب وكيف جلالة شأنه.
فأتيت إلى باب داره، فرأيت الخيل مسرّجة، والرجال واقفين، والحسين× جالس على كرسيّ، وبنو هاشم حافّون به، وهو بينهم كأنّه البدر ليلة تمامه وكماله، ورأيت نحواً من أربعين محملاً، وقد زُيّنت المحامل بملابس الحرير والديباج.
قال: فعند ذلك أمر الحسين× بني هاشم بأن يركبوا محارمهن على المحامل، فبينما أنا أنظر وإذا بشابّ قد خرج من دار الحسين×، وهو طويل القامة وعلى خدّه علامة، ووجهه كالقمر الطالع، وهو يقول: تنحّوا يا بني هاشم، وإذا بامرأتين قد خرجتا من الدار، وهما تجرّان أذيالهما على الأرض حياءً من الناس، وقد حفّت بهما إماؤهما، فتقدّم ذلك الشابّ إلى محمل من المحامل وجثى على ركبتيه، وأخذ بعضديهما وأركبهما المحمل، فسألت بعض الناس عنهما، فقيل: أمّا إحداهما فزينب، والأُخرى أُمّ كلثوم بنتا أمير المؤمنين. فقلت: ومن هذا الشابّ؟ فقيل لي: هو قمر بني هاشم العبّاس بن أمير المؤمنين.
ثمّ رأيت بنتين صغيرتين كأنّ الله تعالى لم يخلق مثلهما، فجعل واحدة مع زينب، والأُخرى مع أمّ كلثوم، فسئلت عنهما، فقيل لي: هما سكينة وفاطمة بنتا الحسين×.
ثمّ خرج غلام آخر كأنّه البدر الطالع، ومعه امرأة، وقد حفّت بها إماؤها، فأركبها ذلك الغلام المحمل، فسألت عنها وعن الغلام، فقيل لي: أمّا الغلام فهو عليّ الأكبر ابن الحسين×، والامرأة أُمّه ليلى زوجة الحسين× [738].
ثمّ خرج غلام ووجهه كفلقة القمر، ومعه امرأة، فسألت عنها؟ فقيل لي: أمّا الغلام فهو القاسم بن الحسن المجتبى، والامرأة أُمّه.
ثمّ خرج شابّ آخر وهو يقول: تنحّوا عنّي يا بني هاشم، تنحّوا عن حرم أبي عبد الله، فتنحّى عنه بنو هاشم، وإذا قد خرجت امرأة من الدار وعليها آثار الملوك، وهي تمشي على سكينة ووقار، وقد حفّت بها إماؤها، فسألت عنها، فقيل لي: أمّا الشابّ فهو زين العابدين ابن الإمام، وأمّا الامرأة فهي أُمّه شاه زنان بنت الملك كسرى زوجة الإمام، فأتى بها وأركبها على المحمل، ثمّ أركبوا بقيّة الحرم والأطفال على المحامل.
فلمّا تكاملوا نادى الإمام×: أَين أَخي، أَين كَبشُ كتيبتي، أين قمر بني هاشم؟ فأجابه العبّاس: لبّيك لبّيك يا سيّدي»[739].
نعم، تعمّد سيّد الشهداء× الخروج بهذه الهيئة والطريقة، فلمّا جاء أبو الفضل العباس: «قال له الإمام×: قَدِّمْ لي يا أَخي جَوادي».
وهذا ما يثير العجب، فالإمام الحسين× ـ وبالرغم ممّن أحاط به من بني هاشم والخدم ـ لم ير أحداً مناسباً ليقدّم له الجواد إلّا قمر بني هاشم[740]. ذلك الجواد الجيّد هو الجواد الذي وصفه الإمام صاحب العصر والزمان# حيث يقول: «رأين النساء جوادك مخزيّاً»[741].
ثمّ قال جدّ عبد الله بن سنان: «فأتى العبّاس بالجواد إليه، وقد حفّت به بنو هاشم، فأخذ العبّاس بركاب الفرس حتّى ركب الإمام، ثمّ ركب بنو هاشم، وركب العبّاس وحمل الراية أمام الإمام»[742].
4ـ ثناء الأئمّة المعصومين^ على أبي الفضل×: من جملة المزايا التي حظي بها قمر بني هاشم× أنّ عدّة من الأئمّة المعصومين قد أثنوا عليه، نشير إلى بعضها:
أـ
لمّا أخبر سيّد الشهداء× أصحابه بأنّه ليس له عليهم بيعة ولا ذمام، فإنّ أوّل من
قام وأبدى استعداده وتضحيته ووفاءه هو أبو الفضل العباس[743]،
فقال
أبو عبد الله الحسين×: «ولا أهل بيت أبرّ ولا أفضل من أهل بيتي»[744]،
وكذلك في عصر تاسوعاء لمّا عزم العدو على مهاجمة مخيّم الحسين× قد أوكل
الإمام× مهمّة الذهاب إلى القوم واستخبارهم عمّا جاء بهم وما يريدون إلى أخيه أبي
الفضل العباس×، فقال: «اركب بنفسي أنت يا أخي» وهذا التعبير (التفدية) عجيب
حقّاً، حيث إنّ الإمام لم يستعمله مع أولاده، ولكنّه قد استعمله مع قمر بني هاشم×.
ب ـ يوماً ما رأى الإمام السجّاد× ابن أبي الفضل العباس بكى، ثمّ قال: «إنّ للعباس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة»[745].
ج ـ يقول الإمام الصادق× ـ عند زيارة قمر بني هاشم ـ : «السلام عليك أيّها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين»[746]، ويقول: «السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه»[747]. نعم، كان أبو الفضل العباس مثالاً رائعاً في المواساة والمساواة، والتضحية والإيثار لأخيه الإمام الحسين×، ومن مظاهر المواساة أنّه رجع من مشرعة الفرات عطشاناً وبشفاه ذابلات، قد جفّ ريقه، وتخشّب لسانه من الظمأ، أنّى له أن يشرب الماء والأطفال في مخيّم الحسين× عطاشى، فكان قمر بني هاشم مظهر الوفاء والفداء، والمواساة والمساواة.
د. قال الإمام صاحب العصر والزمان# في زيارة قمر بني هاشم: «السلام على العباس بن أمير المؤمنين المواسي أخاه بنفسه»[748].
الجدير بالذكر أنّ شهداء كربلاء يُزارون دفعة واحدة، ولكنّ زوّار كربلاء يزورون قمر بني هاشم في ثلاثة أماكن، الأوّل: المكان الذي دفنه فيه الإمام السجّاد× بمساعدة الملائكة، والثاني: المكان الذي قُطعت فيه يده اليمنى، المكان الذي لا زال مزاراً يُحيى فيه ذكره، والثالث: موضع سقوط يده اليسرى.
من جملة شهداء كربلاء طفل رضيع لسيّد الشهداء×، ولعلي الأصغر تأثير كبير في استثارة العواطف الإنسانيّة، ويظهر من كلام سيّد الشهداء× في اليوم الثاني من محرّم حين قال: «هاهنا ـ والله ـ ذبح أطفالنا»[749]، أنّه قد استشهد في كربلاء عدّة أطفال، وكلمة طفل تُطلق ـ أيضاًـ على من لم يبلغ الحلم[750].
ولمّا قال الإمام الحسين× في ليلة عاشوراء إنّ الطفل الرضيع سيقتل غداً، التفت إليه القاسم مستفسراً: أوَ سيهجم الأعداء على الخيام؟! فأجابه الإمام×: لا، ما دمت حيّاً. فقال كيف سيُستشهَد؟ فقال×: يقتلونه حينما يحترق قلبي وأريد أن أسقيه الماء[751].
فبعد أن استشهد علي الأوسط[752] أخذ الأمام× الطفل الرضيع ليطلب له الماء[753]، وفي بعض الأخبار أنّه لم يأت به إلى الميدان، بل كان الإمام إلى جانب الخيمة، يريد أن يودّع العيال، فطلب الطفل الرضيع ليودّعه، وفي تلك الحال جاء سهم فأصاب الطفل وذبحه من الوريد إلى الوريد[754].
من جملة قوانين الصيد أن يضع الصيّاد في القوس السهم المناسب لفريسته التي يريد اصطيادها، فلا يصيد بما يصطاد به العصفور غزالاً، وما يصطاد به الغزال لايصطاد به ما هو أكبر منه، فالسهم المخصّص لقتل الرجال لا يناسب الطفل الرضيع علي الأصغر، ولذا فإنّ ذلك السهم قد ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد: «فذبح الطفل من الأُذن إلى الأُذن»[755]، فوضع الإمام الحسين× يده المباركة تحت نحره، وسال الدم في كفّه حتّى امتلأت، ورماه إلى السماء، قائلاً: «هوّن ما نَزل بي أنَّه بعين الله»[756]، وكان حرملة الملعون هو من رمى ذلك السهم[757].
وجاء ذكر هذه الفاجعة في الزيارة الناحية للإمام صاحب الزمان#، وقد ورد فيها لعن قاتل الطفل الرضيع، حيث يقول الإمام صاحب الزمان# بشأن الطفل الرضيع: «السلام على عبد الله بن الحسين، الطفل الرضيع، المرمي الصريع، المتشحّط دماً، المصعّد دمه في السماء، المذبوح بالسهم في حجر أبيه، لعن الله راميه حرملة بن كاهل الأسدي وذويه»[758]، ولعلّ هذا الطفل هو علي الأصغر. وجملة (المصعّد دمه في السماء) التي وردت في الزيارة لعلّها إشارة إلى ما صنعه سيّد الشهداء× لمَّا استشهد علي الأصغر، حيث وضع كفّه تحت نحره، ورمى بدمه إلى السماء، ويحتمل أن يكون المراد أنّ العقائد والأخلاق والأعمال الطيّبة تصعد إلى السماء (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)[759]، وشهداء من هذا القبيل ـ لا سيّما شهداء كربلاء ـ بسبب تقواهم تصل أعمالهم إلى الله تعالى، كما قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ)[760] فالدماء لا ترقى إلى السماء سواء كانت تلك الدماء دماء الشهيد أو دماء الأُضحية، ولكن تقوى الشهداء والمضحّين هي ما يصل إلى الله تبارك وتعالى.
وبعد قيام ثورة المختار وانتقامه من قتلة شهداء كربلاء، وصل الخبر للإمام السجّاد× في المدينة، فسأل عن حرملة، فقال له المخبر: تركته حيّاً في الكوفة، فرفع الإمام السجّاد× يديه للدعاء، فقال: «اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه حرّ النار».
فاستجاب الله دعاء الإمام السجّاد×، فأُلقي القبض عليه وقتل وحرق[761]، نعم، إنَّه احترق بنار الدنيا، وسيحترق بنار الآخرة. إنّ قتل الطفل الرضيع من أقسى الجرائم التي ارتكبها الأُمويّون، وأصبحت عاراً يلاحقهم، إذ إنّ حياته لم تكن تشكّل خطراً عليهم حتّى يقتلوه.
وطبقاً لبعض الأخبار أنَّ الإمام× قد حفر له قبراً صغيراً بجفن سيفه إلى جانب الخيام ودفنه، وهو الشهيد الوحيد الذي دُفن في حياة أبي عبد الله الحسين×، وتولّى دفنه بنفسه[762]، ولعلّ السر في دفنه؛ لكي لا تطأه حوافر خيل بني أميّة، لا سيّما وأنّ بدن الطفل رقيق لا يتحمّل ذلك، ونقل بعض أهل السير أنّ جسد عبد الله الرضيع وُضع في الخيمة التي جُمع فيها الشهداء[763].
قالت سكينة: فسمعت أبي ـ وأنا عند منحره الشريف، وأنا مغشياً عليّ ـ يقول:
|
ليتكم في يوم عاشوراء جميعاً تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني[764] |
ليتكم ـ يا شيعتي ـ كنتم حاضرين في يوم عاشوراء، وتنظرون إلى ما جرى على رضيعي لمّا استسقيت له ماءً، بعد أن جعل يتضوّر من العطش، أخذته إلى الميدان[765]. وفي تلك الحال لمّا كان الطفل على يدي أبي عبدالله× ذبحوه بسهم ذي ثلاث شُعب، واستشهد علي الأصغر في تلك اللحظة[766].
بعد شهادة الهاشميين الأبطال، جاء دور سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين×، وقد بدأ الإمام الحرب بشكل رسمي بعد ظهر عاشوراء، لاستحباب الحرب بعد الزوال، أو لأنّ الحرب قبل الزوال مكروهة[767]، فالإسلام ليس دين حرب، فمتى ما بدأت الحرب بعد الزوال ستنتهي بسرعة عند حلول الليل، ومن جانب آخر أنّ الدعاء مستجاب عند الزوال وصلاة الظهر[768]، ولعلّه بسبب رقّة القلوب لا تبدأ الحرب، بالرغم من أنّ قتال بعض الأصحاب قد بدأ قبل زوال يوم عاشوراء، وقد استشهد منهم جماعة في ذلك الوقت، لكن صلّى الإمام الحسين× صلاة الخوف بطريقة خاصّة[769]، وبدأ قتال الأعداء بعد الظهر.
لقد قام الإمام الحسين× بوداعين: وداع عام، وآخر خاصّ للإمام السجّاد والسيّدة زينب الكبرى÷، فقال في وداعه العام لمّا اجتمع حوله كلّ أهل بيته: «استعدّوا للبلاء، واعملوا أنَّ الله تعالى حاميكم وحافظكم، وسينجيكم من شرّ الأعداء، ويعوّضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة، فلا تشكّوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم»[770].
وقد ذكر الإمام الحسين× في وصيّته العامّة أنّ أجر هذه الرحلة هو العزّة والكرامة[771]، وقد أوصاهم أن لا يشتكوا مما يرونه من صعوبات وآلام السفر من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، وما يجري عليهم في مجلس الكوفة ومجلس الشام، ولا يفعلوا فعلاً ينقص من قدرهم وشأنهم وجلالتهم.
وقال في وداعه الخاصّ لأخته زينب الكبرى‘: «يا أُختاه، لا تنسيني في نافلة الليل»[772]، ففي كربلاء يدور الكلام حول صلاة الليل والمناجاة مع الله تعالى والزهد بالدنيا وما فيها[773].
ورغم أنّه× أوصى أصحابه ليلة عاشوراء أن يغسلوا ثيابهم ويغتسلوا كي تكون ثيابهم أكفانهم، حيث قال لهم: «واغسلوا ثيابكم لتكون أكفانكم»[774] فقد طلب من السيّدة زينب‘ أن تناوله ثياباً لا يرغب فيها أحد؛ لأنّه يعلم أنّه بعد شهادته ستُسلب ثيابه، قائلاً: «ايتيني بثوب عتيق»[775]، بالرغم من أنّه كان لابساً أبهى الملابس وأجلّها، إذ كان عليه لباس رسول الله’ كي يكون ذلك حجّة بينه وبين الظالمين، لكنّه طلب ثوباً عتيقاً لا يرغب به أحد، فجاؤوا للإمام× بقميص قصير: «فأبى أن يلبسه، وقال: هذا لباس أهل الذمّة»[776]، فقال: «ائتوني بثوب لا يُرغب فيه، ألبسه غير ثيابي»[777] فجاؤا له بلباس آخر، فخرّقه ومزّقه: «لئلّا يرغب فيه أحد»[778] ثمّ لبسه تحت ثيابه، نعم إنّ لباس الشهيد كفنه، فأراد الإمام× أن يستقبل جدّه المصطفى| وأمّه فاطمة الزهراء‘ وأباه علي المرتضى× وأخاه الحسن المجتبى× وهو على رمال كربلاء الملتهبة وجسده مغطّى.
فقال الحرم للإمام الحسين×: «ردّنا إلى حرم جدّنا» فقال×: «هيهات، لو تُرك القطا لنام»[779] أي: كيف يمكنني أن أردّكم إلى المدينة، والعدو قد أطبق علينا، وسدّ كلّ الطرق، فسألته ابنته: «استسلمت للموت؟» فأجابها: «كيف لا يستسلم مَن لا ناصر له ولا مُعين»[780] وفي هذا الحال ارتفعت أصوات النساء بالعويل، فسأل الإمام× ما الخبر، فقيل له: هذا الطفل لا يهدأ، فقال×: «ناولوني... حتّى أودّعه»[781].
ودخل الإمام الحسين× إلى خيمة ولده السجّاد×، وأودعه أسرار الإمامة، واختصر الإجابة على سؤال الامام زين العابدين حول من استشهدوا بقوله: يا بُني، اعلم أنّه ليس في الخيام رجل إلاّ أنا وأنت[782].
ولمّا ودّع أخته زينب‘، نادى: «ألا هل مَن يقدّم لي جوادي»[783]، وبما انّ جميع الأصحاب قد استشهدوا، فلمّا سمعت السيّدة زينب‘ ذلك، استأذنت منه في تقديم الجواد بنفسها، فلمّا أذن لها، أخذت بعنان الجواد. وجاءت أُخته إليه بالجواد، فركب الإمام× جواده، وتوجّه نحو ميدان القتال[784]، واستطاع أنْ يفرّق الأعداء، ووصل إلى شريعة الفرات، ولكنّه وصل إلى الفرات وهو عطشان، وخرج من شاطئ الفرات وهو عطشان؛ لأنّ القادة الإلهيين يلزم عليهم أن يعيشوا حياة أبسط الناس وأكثرهم حرماناً، نعم يلزم على الإمام أن يمضي عطشاناً؛ لأنّه إمام عطاشى الحرم.
عندما توجّه الإمام الحسين× نحو الميدان في الوداع الأخير، نشر القرآن على رأسه، وهو يقول: «بيني وبينكم كتاب الله»[785] أي: علام تقاتلونني وتستحلّون دمي، فإنِّي لست أشراً ولا مبتدعاً في الدين، ولم أرتكب لا ذنباً سياسيّاً ولا ذنباً فقهيّاً، فأجابه بعضهم: «إنّا نقاتلك بغضاً لأبيك»[786]، واحتجّ آخرون ـ وهم مَن يرون أنّ الإمام× خارجي ـ بحجّة أخرى، وهي الخروج على حكومة الحقّ والعدل بزعمهم.
إنّ الإمام الحسين× قد عرض على عمر بن سعد الملعون عدّة اقتراحات، منها: إن لم تتركونا نذهب من حيث أتينا، وقد منعتمونا من الماء، فتعالوا نتقاتل رجل إلى رجل، فردّ ابن سعد كلّ الاقتراحات، ولكنّه قبل بالاقتراح الأخير[787]، ولمّا رأى هزيمته ورجاله يقتلون واحداً تلوى الآخر ـ لأنّه ما برز أحد من جيشه إلّا وقتل ـ فأمرهم أن يهجموا على الإمام× من كلّ جانب، قائلاً: «فاحملوا عليه من كلّ جانب»[788].
وقد ورد في الأخبار أنّه لمّا أمر عمر بن سعد بأن يحملوا على الإمام من كلّ جانب، صار× خلال هذه البرهة ينتقي من بين الأعداء المحيطين به، فینظر بنظرة ملكوتيّة ليميّز أولئك الذين سيخرج من صلبهم شيعة، فيمتنع عن قتلهم[789].
وأراد جماعة أن يحملوا على مخيّم الإمام الحسين×، فقال لهم: «يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم هذه، وارجعوا إلى أحسابكم، إن كنتم عرباً كما تزعمون»[790]. وهذا الكلام يعني أنّكم تدّعون العروبة، وأنا عربيّ أيضاً، وليس من عادات العرب ولا نواميسهم الاعتداء على النساء والأطفال، فلماذا نسيتم حميّتكم وغيرتكم، فأنا الذي أقاتلكم، فما هو ذنب النساء والأطفال؟ فكفّوا عن التعرّض لحرمي ما دمت حيّاً، وعندها أمر الشمر الجيش بالكفّ عن الخيام، فكفّوا عنها[791].
فلما استشهد جميع الأصحاب، جعل الإمام الحسين× ينظر يميناً وشمالاً، فما يراهم إلّا مجزّرين كالأضاحي، عند ذلك نادى: «يا مسلم بن عقيل، يا هاني بن عروة، يا برير، يا زهير، يا عباس» ثمّ رفع صوته بمناداة بعض أصحابه، واصفاً إيّاهم بقوله: «يا أبطال الصفا، ويا فرسان الهيجاء، مالي أُناديكم فلا تجيبون»[792]، ثمّ نادى: «هل مِن ذابّ يذبّ عن حرم رسول الله’؟ هل مِن موحّد يخاف الله فينا؟»[793].
ولمّا ضعف أبو عبد الله× عن الحرب والقتال «فوقف يستريح ساعة»[794] عند ذلك رماه أبو الحتوف بحجر فوقع على جبهته، وسال الدم منها، فوضع يده فلمّا امتلأت لطّخ بها رأسه ولحيته «وقال: هكذا (والله) أكون حتّى ألقى جدّي»[795] «فأتاه سهم محدّد مسموم، له ثلاث شُعب»[796] فوقع في قلب سيّد الشهداء×، فانحنى× وأخرج السهم من ظهره، ولم يتمكّن بعدها من الركوب[797]، وفي هذه الحالة شوهد عمر بن سعد يبكي، فسُئل عن السبب، فأجاب: لِما رأيته من إخراج الحسين السهم من ظهره[798].
|
آينه
بشكست ورخ يار ماند أي عجب اين دل شد ودلدار ماند[799]. |
ثم إنَّ سيّد الشهداء× لم يقو على البقاء راكباً على فرسه فهوى إلى الأرض[800]، ورجع جواده إلى المخيّم[801]، وقد وصف لنا الإمام صاحب الزمان# حالة رجوع الجواد إلى المخيّم، قائلاً: «وأسرع فرسك شارداً، وإلى خيامك قاصداً، محمحماً باكياً. فلمّا رأين النساء جوادك مخزيّاً، ونظرن سرجك عليه ملويّاً»[802]، وكان لكلّ واحدة حديثها مع الجواد، وفي تلك الأثناء توجّهت زينب الكبرى‘، لتفقد صاحب الجواد، فوقفت على التلّ الزينبي كي تراه، وإذا بها تراهم وقد أحاطوا بأخيها؛ هذا يرميه بحجر، وذاك يصيبه بسهم، وآخر يضربه بالسيف، وهنا وضعت يديها على رأسها، ونادت: «أمَا فيكم مسلم»[803].
ولمّا تراجع الجمع قليلاً عن مصرعه، رأت السيّدة زينب‘ الشمر جالساً على صدر سيّد الشهداء×، فقال له وهو غارق بدمه: «فلَقَدِ ارْتَقَيْتَ مُرْتَقىً عَظيماً، طالَما قَبَّله رسُولُ اللهِ’»[804].
وقال بعضهم: إنَّ الشمر ـ لعنه الله ـ قد حزّ رأس الحسين× من الخلف؛ لأنّ سيفه لم يعمل حينما مرّره من الأمام؛ لأنّه موضع تقبيل النبي’[805].
وقد نقل المؤالف والمخالف أنّ الإمام الحسين×، قال: «إلهي، رضاً لرضاك، تسليماً لأمرك، لا معبود سواك»[806]. وهذا خطاب من أنس بمناجاة حبيبه، وانتصر في ميدان الجهاد الأكبر.
ولمّا اقتربت السيّدة زينب‘ من أخيها، أشار إليها بالرجوع إلى الخيمة؛ لأنّ مسؤولية العيال كانت على عاتقها، فرجعت زينب‘ إلى خيمة الإمام السجّاد×، ورأت أنّ الأجواء في كربلاء قد تغيّرت، واهتزّت الأرض، فسألت‘ الإمام السجاد× ـ حجّة الله في أرضه ـ عن سبب تغيّر الكون، فأومأ إليها أن ترفع طرف الخيمة، فسمع التكبير الذي يدلّ على حزِّ رأس الإمام الحسين×، وحمله على الرمح:
|
ويكبّرون بأنْ قُتلتَ وإنّما قتلوا بك التكبير والتهليلاً[807]. |
تُطلق كلمة الفرس على الحصان لما يتميّز به من فراسة وذكاء، وكان فرس الإمام× مدرّباً، ولذا لم يشرب الماء، ورجع عطشاناً عند ما رأى سيّد الشهداء× دخل إلى المشرعة ولم يشرب الماء[808]. كما لم يكن يطيق سقوط الإمام× من على ظهره إلى الأرض؛ لذا مدّ يديه وأثنى رجلين، وقرَّب بطنه إلى الأرض، وأنزل جسم الإمام× إلى الأرض بهدوء، وعندئذ رجع الجواد إلى المخيّم في صورة يتألّم لها الإمام صاحب الزمان#، واصفاً تلك اللحظات الأخيرة المؤذنة بهجوم الأعداء على حرم الإمام الحسين×، واستباحته وسبي نسائه، قائلاً: «ولأبكينّ عليك بدل الدموع دماً»[809]، وبكاؤه× بدل الدموع دماً لرجوع الجواد بلا صاحبه.
وقد بكى أمير المؤمنين× لهذا الموقف أيضاً، وذلك لمّا خاض الإمام الحسين× يوم صفّين حرباً، ورجع منها منتصراً فاتحاً، فسأله رجل عمّا يبكيه وقد رجع الحسين× من الميدان منتصراً سالماً، فأجابه× بأنّه لا يبكي لرجوعه اليوم منتصراً، وإنّما يبكي ليوم سيرجع فيه جواده خالياً منه [810].
وقد فسّر أمير المؤمنين× حمحمة الفرس، وذكر أنّه يقول: «الظليمة الظليمة لأمّة قتلت ابن بنت نبيّها»[811]، عندها اجتمع الكل حول الجواد، أمّا زينب فأخذت تنادي: واحسيناه واحسيناه، وهي واقفة على التلّ المعروف بالتلّ الزينبي، ولمّا رأت الهجوم الأُموي اللئيم الجبان على سيّد الشهداء×، قالت: «أما فيكم مسلم»[812]، وسألت عمر بن سعد الملعون: «أيُقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه»[813].
ونحن نقول في الزيارات: «السلام عليك يا بن رسول الله...، يا بن فاطمة الزهراء»[814] أمّا الإمام صاحب الزمان# فإنّه يسلّم على جميع أعضاء أبي عبد الله الحسين×، حيث يقول: «السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخدّ التريب...»[815].
سيّد الشهداء× وهو في مصرعه، يلهج لسانه بكلمة (ربّ) من دون حرف النداء، مع أنّ من آداب الدعاء قول (ياربّ، ياربّ، ياربّ)، وذلك أنّ الإمام لمّا رأى نفسه قريباً من الله}، صار يردّد: (ربّ ربّ ربّ) دون حرف النداء؛ إذ عندما يحصل القرب الإلهي تتحقّق المناجاة لا الدعاء.
لمّا رجع فرس الإمام الحسين× دون راكبه إلى المخيّم صاهلاً، خرجن النساء حاسرات، حيث يصف الإمام صاحب الزمان# هذه اللحظات المفجعة للقلوب، قائلاً: «فلمّا رأين النساء جوادك مخزيّاً، ونظرن سرجك عليه ملويّاً، برزن من الخدور، ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات الوجوه سافرات، وبالعويل داعيات»[816].
من أفجع أحداث كربلاء وآلمها بعد شهادة الإمام الحسين×، هجوم جيش ابن سعد على المخيّم عصر يوم عاشوراء، ونهب كلّ ما فيه، وسلب حرمه وترويعهم[817].
فبالرغم من وجود الخندق المليء بالقصب الذي يحيط بالخيام، وكان قد تمّ حفره وحرق ما فيه من القصب للمنع عن هجوم العدو على المخيّم، إلّا أنّ واجهة المخيّم بقيت مفتوحة بعد ما كان يسدّه الإمام والأصحاب[818].
ولمّا هجم القوم عصر يوم عاشوراء على مخيّم الحسين×، قال الإمام زين العابدين×: «عليكنَّ بالفرار»[819] إلّا أنّه لم يكن أمامهنّ إلّا طريقاً واحداً، وهو الذي دخل منه الجيش للسلب والنهب، ممّا صعّب الفرار من المخيّم والنجاة من العدو.
ولمّا بدأ الليل يخيّم عليهم في ليلة الحادي عشر، حاول الجيش الأُموي إيصال رؤوس الشهداء إلى دار الإمارة؛ ليستلموا الجائزة، بعد ما تقاسموا الرؤوس[820]. كما أنّهم سلبوا كلّ ما كان على جسد سيّد الشهداء×، أمّا ذلك القميص الممزّق الذي لبسه كي لا يُسلَبه، فقد مزّقته حوافر الخيل.
ولم يبق ليلة الحادي عشر لأهل البيت^ خيمة إلّا خيمة واحدة قد احترق نصفها، وبعد أن انتهى هجوم الأعداء عليهم، أمر الإمام زين العابدين× النساء والأطفال بالرجوع إلى المخيّم، واجتمعوا في مكان واحد، وعندها علموا بموت بعض الأطفال عند فرارهم[821].
خيمة دار الحرب هي الخيمة التي جُمعت فيها الأبدان الطاهرة للشهداء، والله أعلم كيف كان حال النساء الأسيرات وإلى جوارهنّ تلك الأجساد. يا ترى كيف مرّت عليهنّ تلك اللحظات؟! جميع أبدان الشهداء من الأصحاب وبني هاشم وضعت هناك إلّا جسد أبي عبد الله الحسين× وجسد أبي الفضل العباس×. وبعد ما جرى على العيال والنساء والأطفال من محن وآهات، لم يبق لديهنّ قدرة على البكاء والنوح على الشهداء. وهي الليلة التي حملوا فيها رأس الإمام الحسين× إلى الكوفة[822].
لمّا ارتحل النبيّ الأكرم’ بكلّ جلالة وهيبة، كان رأسه المبارك في حضن علي ابن أبي طالب×[823]، وقام الإمام علي× بتغسيل النبي’ بنفسه، وانفرد في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وكانت الملائكة تختلف وتتوافد للصلاة عليه «والملائكة أعواني... وما فارقت سمعي هينمة منهم»[824]، وهذا يعني أنّ دويّ توافد الملائكة وأصواتهم لم ينفصل عن أُذن أمير المؤمنين× لحظة، ثمّ ورد عن أمير المؤمنين× أنّه لمّا كان يغسّل النبي’ كان بحاجة إلى الأعوان، ولا يحقّ لأحد أن يعينه أو يشاركه في تغسيله؛ لأنّه ليس لغير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب× الاستعداد واللياقة في تغسيل النبي’.
وكذلك لمّا استشهدت فاطمة الزهراء‘، فقد قام أمير المؤمنين× بتغسيلها بنفسه، نعم فاطمة الزهراء قد استشهدت بجلالة وعظمة، وقد سمع علي بن أبي طالب× وصاياها، وتكفّل تجهيزها والصلاة عليها ودفنها[825]، وإن لم يُعرف موضع قبرها المطهر.
ولمّا جاء الدور إلى شهادة أمير المؤمنين×، فقد قام الإمام الحسن× بتغسيله، وقد عاونه الإمام الحسين× في تغسيل أبيه[826]، ولمّا استشهد الإمام الحسن× قام الإمام الحسين× بتغسيله وتكفينه[827]، وكان أبو الفضل العباس بن علي× يصبّ الماء ويساعد أخيه في تغسيل الإمام المجتبى× [828]، ولكن لمّا جاء يوم استشهاد أبي عبد الله الحسين×، فلا بدّ أن نقول: «لا يوم كيومك يا أبا عبد الله»[829].
ما أفجعه من يوم وأعظم مصيبته، ذلك اليوم الحادي عشر من المحرّم لعام واحد وستّين للهجرة، وما أشدّه على أهل البيت×، ففي هذا اليوم مرّت السيّدة زينب الكبرى‘ وبقيّة أهل بيت الإمام الحسين× على مصارع شهداء كربلاء، وما أصعب هذه اللحظات على أهل بيت أبي عبد الله^.
إنّ أكثر الأجساد الطاهرة كان قد حملها الإمام الحسين× إلى المخيّم، فكانت أغلب الأجساد في خيمة دار الحرب[830]، ولم يبق في ميدان الحرب إلّا الأجساد الطاهرة التي لم يمكن حملها، أو هناك ما أوجب بقاءها، كجثمان أبي الفضل العباس× وجثمان الإمام سيّد الشهداء×.
ولمّا جاءت السيّدة زينب الكبرى‘ إلى جسد أخيها، مسحت التراب عن مواضع ضرب السيوف وطعنات الرماح، والأماكن التي رضّتها[831] حوافر الخيل: «وبجرد الخيل بعد القتل عمداً سحقوني»[832]. ثمّ وضعت يديها تحت الجسد الطاهر ورفعته قليلاً إلى الأعلى، وقالت ـ مخاطبة ربّ العزّة والجلالة ـ : «إلهي تقبّل منّا هذا القربان»[833]، وهذا الموقف ليس موقفاً بسيطاً، ولا يتسنّى لأيّ أحد أن يدعو بهذا الدعاء، فهو يشبه دعاء إبراهيم الخليل وإسماعيل الذبيح÷ عند بناء الكعبة، حيث قالا داعيين: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)[834].
ثمّ توجّهت السيّدة زينب‘ إلى المدينة، أو إنّها رأت رسول الله’ وهي إلى جانب ذلك الجثمان، فنادت: «وا محمداه...، هذا حسين مرمّل بالدماء...، مقطّع الأعضاء...، مسلوب العمامة والرداء»[835]
این کشته فتاده به هامون حسین توست – وین صید دست وپا زده در خون حسین توست[836].
نعم، هذه سفينة نجاة الأُمّة التي قال في حقّها رسول الله’: «إنَّ الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة»[837]، قد انكسرت بسبب طوفان وحوادث كربلاء المفجعة، وغرقت بالدماء.
کشتی شکست خوردۀ توفان کربلا- در خاک وخون تپیده میدان کربلا[838]
السيّدة سكينة تسأل عمّتها السيّدة زينب‘ عن الجسد الذي تنوح عليه، قائلة: «عمّتي هذا نعش مَن؟» فقالت السيّدة زينب‘: «هذا نعش أبيك الحسين×» ولا تلام هذه البنت إن لم تعرف أبيها، فجسد سيّد الشهداء× كان جثّة بلا رأس، ولم يسلم فيه عضو، فأرادت سكينة أن تبقى عند جثمانه الطاهر ولكن جاء جلاوزة بني أمّية فجرّوها وسحبوها عن جسد أبيها «فاجتمعت عدّة من الأعراب حتّى جرّوها عنه»[839].
وقد دار حديث بين الإمام زين العابدين× والسيّدة زينب‘ حول جثمان سيّد الشهداء× في يوم الحادي عشر، في الوقت الذي كان فيه الإمام السجّاد× متأثّراً جدّاً، سألته السيّدة زينب‘: «ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وأخوتي»[840]، وذكر في جوابها ـ ما مضمونه ـ : ألا ترين القوم قد دفنوا قتلاهم، وبقي شهداؤنا على التراب، ولا يسمحون لنا أن ندفن ابن بنت رسول الله’[841]، نعم سيأتي قوم يعرفهم أهل السماء، ولا يعرفهم أهل الأرض، فيوارون هذه الأجساد والأبدان الطاهرة، وستتحوّل هذه البقعة إلى مدينة، «وكأنّي الآن أرى الأسواق التي تحفّ بقبر الحسين×»[842] وهذا يعني أنّ أرض نينوى وصحراء كربلاء ستصبح ـ يوماً ما ـ مدينة عامرة.
ولمّا توجّهت السيّدة زينب‘ نحو الكوفة، قد حنّ قلبها إلى أخيها الذي بقي على رمضاء كربلاء جثّة بلا رأس، ولكن لم يمض وقت طويل حتّى استقبلها رأس الحسين× مرفوعاً على القناة عند باب الكوفة.
ولمّا حان وقت المسير نحو الكوفة، ركبت السيّدة زينب‘ على الناقة، وما أشدّ الاختلاف عن حالة خروجها من المدينة لمّا أركبها قمر بني هاشم× على ناقتها بذلك الجلال والوقار والعزّ، ولكنّها اليوم تنظر يميناً شمالاً لا تجد من حماتها حمي، فطلبوا من جلاوزة بني أُميّة التنحّي عنهم كي يركّب بعضهم بعضاً، وقد أركبت تلك البنت التي أجلستها أمامها حين خروجها من المدينة[843] على ناقتها، وقد ساروا تلك المسافة التي بين كربلاء والكوفة متحمّلين تلك المحن والمصاعب.
وقد أسرعوا بأخذ الرؤوس إلى الكوفة لاستلام الجائزة، ولذا فالسيّدة زينب‘ وبقيّة أعضاء القافلة، لم يروا رأس الحسين× وسائر رؤوس الشهداء في ليلة الحادي عشر، ولكنّهم على أعتاب الكوفة وقعت أعين الأطفال والسيّدة زينب× على تلك الرؤوس، وفي مقدّمتها الرأس الطاهر لأبي عبد الله الحسين×.
إنّ لأبناء أبي عبد الله الحسين× منزلة عظيمة ومكانة رفيعة، ولو علمنا منزلتهم ومقامهم لما هدأ أنيننا يوم عاشوراء، وقد ذكر أهل السير أنّ الحسن المثنّى بن الحسن المجتبى قد خطب من عمّه الإمام الحسين× واحدة من بناته قبل واقعة عاشوراء، فأجابه الإمام× بما مضمونه: أنّ ابنتي فاطمة كأمّي فاطمة، تتمتّع بكمالات، وهي ربّة بيت جيّدة، فهي تستطيع أن تعيش معك، وأمّا سكينة[844] فهي لا تناسب حياتك التي تريد؛ لأنّها «فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى»[845]، وكأنّها ليست في عالم الدنيا، وأنت تريدها زوجة وربّة بيت لك فستصعب حياتك معها. وكان للسيّدة سكينة مقام ودرجة بحيث انكشف لسمعها وبصرها العالم الملكوتي، ولذا سمعت دون من حضر عند جسد المولى أبي عبد الله× تلك الرسالة التي صدرت من منحر أبي عبد الله الحسين×، وأوصلتها إلى الشيعة؛ لأنّ الإمام الحسين× لم يُفصح عن تلك الرسالة بصوت يخرج من اللسان والشفتين، وإنّما هو صوت ملكوتي[846].
وقد قامت السيّدة زينب‘ والسيّدة سكينة‘ بإدارة قافلة كربلاء على أحسن وجه، ولمّا أردن وداع تلك الجثث الزاكية والأجساد الطاهرة فإنّما جلسن عند أجساد بلا رؤوس، وقبّلن تلك المناحر حيث لا موضع للتقبيل[847]. إلّا أنَّه لم ينقل أحد رسالة عن سيّد الشهداء×، ولم يسمع أحد كلاماً من الإمام الحسين× كي ينقله لنا، إلّا السيّدة سكينة‘، وهذا يدلّ على مكانتها السامية ومنزلتها وقربها الذي كان يراه فيها الإمام الحسين×، ونُقل عن سكينة بنت الحسين×، أنّها قالت: لمّا قُتل الحسين×، اعتنقته فأغمي عليَّ، فسمعته يقول:
|
شيعتي ما إن شربتم |
إنّ العلماء الكبار يسعون لسنين متمادية بقرن العلم مع السلوك الباطني عسى أن يحظوا بقطرة من جلال وعظمة السيّدة سكينة‘. قد يصبح الإنسان الاعتيادي بواسطة الدروس الكسبيّة عالماً مجتهداً، ومع ذلك لا يمكنه الاطّلاع على الغيب.
إنّ الإمام الحسين× وهو في مصرعه، قد أرسل من منحره هذه الرسالة إلى شيعة أهل البيت^، وتمّ إيصالها لهم بواسطة السيّدة سكينة‘، والغرض من ذلك إحياء اسم أبي عبد الله الحسين×، وتجديد ذكره ليلاً ونهاراً، وفي كلّ مرّة يشرب الشيعي الموالي الماء، والمصرع الثاني من البيت يطلب فيه الإمام× ندبته، فإن سمع الشيعي الموالي بغريب أو بشهيد فينبغي أن يتّخذ ذلك ذريعة لندبة الحسين× والبكاء عليه، لا بالعكس بأن يجعل الإمام الحسين× وسيلة لندبتهما والكباء عليهما.
قد برز دور السيّدة زينب الكبرى‘ وعظيم منزلتها في رحلة كربلاء؛ لأنّها أُلقيت على عاتقها مسؤوليّة الحفاظ على الأطفال والنساء وتدبير شؤونهم وإدارة أمورهم، هذا من جانب ومن جانب آخر كانت هي قائدة قافلة أهل بيت الحسين× في سفرهم من كربلاء حتّى المدينة، ومن جانب ثالث: كان عليها القيام بدورها الإعلامي في نهضة كربلاء، وإيصال رسالة تلك النهضة العظيمة إلى العالم، ولذا فإنّ السيّدة زينب‘ كانت من أقوى وأهمّ العناصر السياسيّة والأساسيّة في كربلاء، وظهر هذا الجلال وهذه العظمة الفاطميّة بشكل واضح عند هذه السيّدة بعد اليوم الحادي عشر، فإنّ من عظيم منزلة هذه السيّدة الجليلة أن يطلب سيّد الشهداء× منها أنْ تدعو له في صلاة الليل ـ كما تقدّم ـ حيث قال لها: «يا أختاه، لا تنسيني في نافلة الليل»[849]، وقال الإمام السجّاد× بحقّها: «أنت ـ بحمد الله ـ عالمة غير معلّمة، فهمة غير مفهّمة»[850]، وهذه شهادة للسيّدة زينب‘ من قبل حجّة الله في أرضه الإمام السجّاد×.
وفي ليلة الحادي عشر والثاني عشر من محرّم لم تتهيّأ فرصة للاستراحة ممّا جرى عليهم من المصائب والمحن، إلّا أنّ زينب الكبرى‘ أقامت صلاة الليل من جلوس رغم أفضليّة أدائها من قيام؛ لأنّها لا تقوى على الوقوف[851].
وكانت السيّدة زينب‘ تبكي وتنوح عند أخيها أبي عبد الله الحسين× الذي ضل جسداً بلا رأس، وصارت تحلّق في آفاق عالية جدّاً، فلم تكتف بمجرّد الصبر، بل كانت مسرورة وشاكرة، والشاهد على هذا أنّها لمّا جاءت إلى مصرع أخيها لتودّعه، تركت العتاب والنوح والعاطفة جانباً، ووضعت يديها تحت جثمانه الطاهر، وقالت: «إلهي تقبّل منّا هذا القربان»[852]، وهذا يعني أنّنا قد ساهمنا في تقديم هذا القربان، فهو قدّم مهجته في سبيلك، ونحن شاركناه في هذه التضحية، وتحمّلنا أعباء الأسر.
إنّ الإمام الحسين× أوصى أخته زينب الكبرى‘ عدّة مرّات بالصبر والتحمّل، وكانت المرّة الأخيرة التي أوصاها بذلك في يوم العاشر من المحرّم، وقد تمكّنت‘ من العمل بهذه الوصيّة، فإنّ ما حظت به من ولاء وجلال وعظمة أعطاها قوّة التحمّل والصبر على تلك الفجائع والمحن العظيمة التي جرت يوم عاشوراء وليلة الحادي عشر.
وفي نهاية المطاف وبعد كلّ ما تحمّلته في صبيحة ليلة الحادي عشر من المحرّم، من آهات ومحن إلى جانب جثمان أخيها، تحرّكت زينب‘ مع قافلة الأسارى نحو الكوفة، ومرّوا بهم على جثث القتلى، ولمّا اقتربت القافلة من مداخل الكوفة جاء الأمر بإيقافهم حتّى يأتوا برأس سيّد الشهداء ليكون أمام القافلة، وقد دخل الركب إلى الكوفة بمراسيم خاصّة، يتقدّمه رأس سيّد الشهداء× على القناة يتلو القرآن: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا)[853].
لكن ليس كلّ أُذن لديها الاستعداد لسماع هذه التلاوة، ولا يسمع هذا الصوت إلّا الأوحديّ من الناس كأهل بيت الحسين× الذين سمعوا صوت تلاوته؛ لأنّها كانت بصوت ملكوتي، لا بلسان ظاهري كي يسمعه الجميع[854]، ولمّا سمعت السيّدة زينب‘ تلك التلاوة اطمأنّت وهدأت، وما ورد من أنّها: «نطحت جبينها بمقدّم المحمل»[855] فعلى تقدير صحّته كان هذا الفعل قبل سماع تلك التلاوة.
حينئذ وبما أنَّ الخسوف يحدث عادة في ليلة الثالث عشر أو الرابع عشر من الشهر القمري، فكأنّي بزينب الكبرى‘ تخاطب ذلك الرأس: يا هلال زينب، لمّا نلت مقام الإمامة الرفيع، وأضاء نورك جميع العالم، وأصبحت بدراً تامّاً، حدثت واقعة كربلاء، وأصبح قمر زينب مخسوفاً. يا أخي، إنّي سمعت بواقعة كربلاء، وتوقعت حصول كثير من حوادثها وسمعت بعضها منك، ولكنّي لم أتوقع أن أرى مثل هذا الموقف أبداً، بأن أكون على المحمل، وابنتك في المحمل أمامي، و رأسك على القناة:
|
يا هلالاً لّما استتمّ
كمالاً |
يا نور عيني، أنت قطعة من كبدي، بل أنت مهجتي وأنا مهجتك، ونحن مهجة واحدة انقسمت نصفين؛ نصف قد مضى شهيداً، والنصف الآخر قد راح أسيراً، كنّا نتوقّع الشهادة، إلّا أنّ الذي لم يكن في الحسبان أن أرى رأس ابن رسول الله| على القناة بذريعة الحفاظ على الدين:
|
ما توهّمت يا شقيق فؤادي |
يا أخي، قد صدرت من رأسك كرامات لم تصدر من غیره، أخذ يتلو القرآن... يتكلّم...، وهذه ابنتك تسمّرت عيناها وهي تنظر إليك، قلبها الصغير يكاد يذوب من شدّة اللوعة، ألا كلّمتها قليلاً؛ ليسكن روعها.
|
يا أخي، فاطم الصغيرة كلّمها فقد كاد قلبها أنْ يذوبا[858]. |
وقد حضرت السيّدة زينب‘ وعليها عظمة أمّها وعزّتها وجلالها في مجلس ابن زياد الملعون، ولمّا سأل هذا الرجس: «كيف رأيت صنع الله بأخيك؟» قالت: «ما رأيت إلّا جميلاً»[859]؛ لأنّ هدف هذه السيّدة الجليلة هو الهدف السامي للإمام الحسين×، ذلك الهدف السامي هو إحياء الدين، وقد تحقّق هذا الهدف بعد تركها تلك المصارع. فقال ابن زياد: إنّها سجّاعة كأبيها علي، فقالت: ما لي والسجع والقافية، سألتني فأجبتك[860]، ثمّ عزم على قتل زينب‘، ومُنع من هذا العمل.
ثمّ أشار إلى الإمام السجّاد×، وقال «من ذلك الشاب؟» فقيل له: علي بن الحسين×، فقال «ألم يقتل الله علياً في كربلاء»، فقال الإمام السجّاد×: «قد كان لي أخ يسمّى علياً، قتله الناس»، فقال: إنِّي أقول قتله الله، فقال الإمام السجّاد×: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)[861]. في هذه اللحظات صدر الأمر بقتل الإمام السجّاد×، ولكنّ السيّدة زينب‘، قالت: ما دمت حيّة لا أسمح لك بارتكاب هذه الجريمة، فقال ابن زياد: «عجباً للرحم»[862]، ثمّ قال الإمام السجّاد× لعمّته زينب: أنا أُجيبه، فقال: «أبالقتل تهدّدني»، وكرامتنا من الله الشهادة، إن عزمت على قتلي لا بدّ أن ترسل محرماً مع هذه القافلة ليوصلهم إلى المدينة[863].
على أساس بعض الأخبار كانت فاطمة الزهراء‘ تناغي ولدها الحسين×، قائلة: «أنت شبيه بأبي، لست شبيهاً بعلي»[864] ومع أنّ ملامح الطفل تتغيّر تدريجياً، وتأخذ بالتغيير خلال مراحل الصبا والشباب والكهولة والشيخوخة، فلا تبقى ملامح الطفل على حالة واحدة حتّى آخر العمر، إلّا أنّ أصل الشبه يبقى، وفاطمة الزهراء‘ كانت تذكر ذلك عند مناغاتها لولدها، وانتبه إلى ذلك الشبه برسول الله’ بعض من كان حاضراً في مجلس يزيد الرجس في الشام، ورأى رأس الحسين× وهو في الطشت، وهكذا مَن رأوا رأس الحسين× على القناة، قالوا إنّنا لنرى وجهاً فيه ملامح رسول الله’. إذن فأصل الملامح كانت في الحسين× منذ الصغر، وبقيت حتّى أواخر عمره وبعد شهادته، وهذا ـ بحسب الظاهر ـ قول النبي’: «حسين منّي وأنا من حسين»[865]، كما قال أبو عبد الله× بحقّ علي بن الحسين×: «اللهمّ اشهد، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك»[866]؛ لأنّ علياً كان شبيهاً بالحسين×، والحسين× كان شبيهاً برسول الله’.
إرشادات إلى أصحاب العزاء على سيد الشهداء×
1ـ إنّ إقامة العزاء على سيّد الشهداء× فيه رمز كرامة المجتمع الإنساني، لا سيّما العالم الشيعي، ويجب النظر إليه على أنّه مصدر فخر واعتزاز. إقامة هذه المراسيم من أفضل ذخائر النظام الديني وثرواته؛ إذ به ستتسلّح الأمّة الإسلاميّة بسلاح الأنبياء، ويُنتزع سلاح الأعداء، فهم يريدون إبقاء المسلمين على جهلهم، فكانت محاولاتهم ولا زالت حتّى الوقت الراهن مستمرّة بواسطة سلكهم الإعلامي من فضائيات وغيرها، تعمل جاهدة على حرف المسلمين وتضليلهم، خشية أن يصبحوا عالمين عاملين.
2ـ ينبغي المشاركة في العزاء بنيّة خالصة، متمحّضة لإرضاء الله} كي نتمكّن من أداء ولو جانب صغير من الدَين الذي على عاتقنا تجاه الإمام الحسين× ونهضة كربلاء، وينبغي أن يكون ما تقوم به الهيئات والمواكب قائماً على أساس تهذيب النفس وتزكيتها، بعيداً عن الدوافع والأعمال غير الصحيحة.
3ـ ينبغي أن تكون المشاركة في مجالس العزاء المقامة على أهل البيت^، لا سيّما يوم عاشوراء، واسعة شاملة للجميع، ابتداءً من الأطفال والصبيان والشباب، وانتهاءً بالكهول والشيوخ، فتشارك كلّ واحدة من هذه الفئات المجتمعيّة بقدر وسعها؛ لتضجّ المدن والقرى وتعجّ مع أهلها بالعويل والهتافات، والله يعلم عظمة ثواب هذه الأعمال! كما يتوجّب على كبار كلّ مدينة ممن يتمتع بالوجاهة والإحترام أن يزيد من وجاهته واحترامه بالمشاركة في المجالس الحسينية، رغم أنّه لا يُتوقّع منهم الاستمرار بإقامة العزاء ومواصلته كالشباب حتّى نهاية برامج العزاء، ومن المناسب للمعزّين المشاركة في مراسيم العزاء في حسينيات مختلفة، وعدم الاكتفاء بالمشاركة في مكان واحد والاقتصار عليه.
4ـ لا ينبغي لأحد أن يبقى متفرّجاً على مراسيم العزاء، إذ يجب على الجميع المشاركة فيها بفعّالية وندبة وبكاء على أهل البيت^. إنّ البكاء على الشهيد يُنتج شوقاً للشهادة في القلوب، ويُثير العواطف العقلائيّة، فإذا عرفنا رمز نهضة سيّد الشهداء× سنعرف السبب في وجود الحثّ والتأكيد على البكاء لمصيبة سيّد الشهداء×. وقد ورد في بعض الأخبار أنّه إذا ذُكر سيّد الشهداء× عند الإمام الصادق× لا يُرى مبتسماً طيلة ذلك اليوم «ما ذُكر الحسين× عند أبي عبد الله في يوم قط فرُئي أبو عبد الله مبتسماً في ذلك اليوم إلى الليل»[867]. إنّ دماء الشهيد والبكاء عليه تولّد عند الإنسان شهامة ونبل، ولذا نجد أمير المؤمنين× يخاطب الحسين×، ويقوله له: «أنت عبرة كلّ مؤمن»[868].
5ـ لا ينبغي لأحد ـ لا سيّما الجيل الجديد ـ الدخول إلى الهيئات الحسينية ومواكب العزاء بلا وضوء، وعلى الإنسان أن ينوي عند الوضوء بهذه النية: أتوضّأ للطهارة كي أدخل إلى عزاء الإمام الحسين× وأنا على طهارة.
6ـ ينبغي إقامة العزاء على سيّد الشهداء× بشكل عقلائي وبسيط ومن دون زخارف، وبناء على هذا عليكم التقليل من الاهتمام بالشكليات، وعليكم رفع مستوى الاهتمام بالمضمون، فالمجالس الحسينيّة هي وسيلة لتغذية الروح بالمسائل الاعتقاديّة والثقافيّة، ومن يشارك في مراسم عزاء أهل بيت العصمة والطهارة ينبغي أن ينتفع من بركاتها، والاستفادة منها كي يصبح نقيّاً من غبار الطبيعة ولوثها، فما دام يعيش الإنسان في هذا العالم المادّي، فإنّه لا مناص أن يكون دائماً في معرض التلوّث، وعليه تطهير نفسه وتزكيتها وتنقيتها.
وللإمام الباقر× في معنى (أمير المؤمنين) كلام لطيف جدّاً وعالي المضامين، حيث إنّه يفسّرها تفسيراً مخالفاً لما هو المعروف بين اللغويين من أنّ معناها (القائد)، إذ يرى أنّها مأخوذة من الميرة، أي: الطعام، وقد جاءت كلمة من هذا القبيل في سورة يوسف× (وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ ... وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ)[869]حيث قال أُخوة يوسف× ليعقوب×: نحن نجلب لأهلنا الميرة، أي: الطعام، وبناء على هذا فأمير المؤمنين هو الشخص الذي يُغذّي الإنسان بالطعام، وعلي بن أبي طالب× يغذّي هذه الأمّة بالطعام المعنويّ الخالص، فهو أمير المؤمنين، وغذاء هذا الأمير هو العلم والمعرفة[870]، إنّ الإمام علي× كان يُذيق أصحابه والمؤمنين الصفات الكماليّة التي كان يتمتّع بها، فالمفترض أن تُوفّر الأرضيّة المناسبة في المجالس الحسينيّة لهذا النوع من الإطعام، بالرغم من أنَّ الإطعام المادّي أجره وثوابه محفوظ.
7ـ هناك عنصران يجب إظهارهما وإبرازهما في المحاضرات والشعارات، سواء بصورة نثريّة أو شعريّة، وهما: محاربة الطاغوت في كلّ عصر ومحاربة الاستكبار العالمي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكشف عن مثالب ومعايب السلالة الأُمويّة القذرة، وهذه هي مهمّة الخطباء وقرَّاء المجالس الحسينيّة، ويجب عليهم بيان معارف هذه النهضة وأسرارها التي تصبّ في بيان هدف سيّد الشهداء×.
8ـ إنّ الأشعار والشعارات ينبغي أن تكون نافعة ومؤثّرة، وعلى روّاد المجالس والمواكب إدارة هذا الأمر المهم، فيجب أن تكون الشعارات مقتبسة من المعارف القرآنيّة وتعاليم أهل البيت^، ورثاء أهل البيت× له أهمّية بالغة في الدين، وكان له دور كبير في دعم الجمهوريّة الإسلاميّة في فترة الدفاع المقدس.
إنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب× لمّا رأى الناس قد دخلوا ميدان السياسيّة والاقتصاد، وجد نفسه مكلّفاً بقبول الحكومة، ولذا قال: «لولا حضور الحاضر، وقيام الحجّة بوجود الناصر...، ولسقيت آخرها بكأس أوّلها»[871]، إنَّ الإمام× كان جليس البيت لخمس وعشرين سنة، ولكن لمّا أصبح الناس مستعدّين لتقبّل الحكومة العلويّة، دخل الإمام ميدان السياسة. ولو افترضنا عدم الناصر لبقي الإمام منزوياً، فمشاركة الناس وحضورهم في ميدان السياسة ركن أساسي. ويبرز الدور المصيري لدراسة نهضة الإمام سيّد الشهداء× في مشاركة الناس على الصعيد السياسي، فحبّ الإمام الحسين× والشهادة كانا المحفّز الأساس لتوافد الناس إلى ميدان السياسة، ولهذا السبب حثّ الأئمّة^ على ذكر واقعة كربلاء وإحيائها بشكل كامل.
9ـ لاينبغي لأحد أن يضيف شيئاً جديداً إلى مراسيم العزاء، ومثل حمل المنصّات الحديديّة الثقيلة خلال المواكب، لا يوصل رسالة ولا يُجدي نفعاً، فعلينا التقليل من مثل هذه الأمور، والتركيز على تعظيم شأن العزاء، وأمّا بالنسبة إلى حمل الرايات واللافتات فلعلّه يتضمّن صبغة إجلال وتعظيم، فالمطلوب هو دراسة نماذج الطقوس التي تُمارس في العزاء، ومعرفة أيّ منها كان موجوداً في العزاء، أو أيّ منها يجب أن يوجد، وأيّ منها لم يكن في العزاء سابقاً وعدمه أفضل. فلماذا نترك الأعمال عظيمة الأجر كالتحفّي واللطم على الرؤوس والصدور طلباً لرضا الله تعالى، ونحمل تلك المنصّات الثقيلة على أكتافنا؟! علينا أن نسير وفقاً لتعاليم القرآن الكريم وإرشادات العترة الطاهرة^، فإذا كان الطريق الصحيح واضحاً ومفتوحاً، فلماذا نسلك الطريق غير الآمن؟!
10ـ ينبغي تنظيم برامج المواكب والهيئات بالنحو الذي يمكن فيه عند سماع الأذان أداء الصلاة جماعة في مكان واحد أو عدّة أماكن، سواء كان ذلك في مسجد أم في حسينيّة، وإن كانت إقامة صلاة الجماعة أمراً غير مقدور، فلا يُغفل عن أداء الصلاة في أوّل وقتها فرادى في المسجد كي ينسجم العزاء مع سيرة المعزّى، وكذلك يجب تأخير الإطعام إلى ما بعد إقامة الصلاة.
11ـ أن تحيى ليالي العَزاء في البيوت بحكاية قصّة كربلاء للأولاد والأحفاد، ولا ينبغي أن يقضوا الليالي ـ ولا سيّما الطويلة ـ بمشاهدة الأفلام غير التربويّة، إذ إنّ الأُمور ذات العبرة ستقرّ في أذهان الصبيان. حيث ينبغي شرح أسس الصراع الدائر بين الصالحين والأشرار؛ لأخذ العبرة منه، ونعلّم أطفالنا ونعوّدهم على الإتيان بذكر (السلام عليك يا أبا عبد الحسين×) عندما يشربون الماء.
12ـ رعاية حرمة التربة الطاهرة لسيّد الشهداء×، فمن المناسب بحسب التعاليم الدينية أخذ مقدار قليل من التربة وخلطه بالماء وتحنيك الرضيع به[872] حتّى يصبح الطفل حسينيّاً بتذوّقه لذلك الماء، ويظلّ لسانه يلهج باسم سيّد الشهداء× طيلة عمره، كما وورد الاستحباب بالإفطار صباح يوم عيد الفطر بمقدار من التربة الحسينيّة[873].
13ـ إنّ حفظ الدماء الطاهرة التي بذلها سيّد الشهداء× يوجب علينا زيارة هذا الإمام المظلوم كلّ يوم بإحدى الزيارات المرويّة كزيارة عاشوراء أو زيارة وارث، ليبقى هدف الإمام× حيّاً، ولا يقتصر ذلك على فئة دون أخرى، فعلى جميع الناس القيام به دون استثناء، والكل فيه سواء، عامّة الناس أم العلماء والنخب من فقهاء وحكماء ومتكلّمين ومفسّرين وعرفاء.
فلا ينبغي الغفلة عن الدروس البنّاءة المستوحاة من زيارة عاشوراء، كقوله: «إنّي سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم»، كثيرون هم أمثال يزيد في العصر الحاضر في الدول الإسلاميّة، ممّن يبيع الوطن والشعب للأجانب مجّاناً، ولو كان سيّد الشهداء× حاضراً في عصرنا لما سمح للأعداء أن يقتلوا المسلمين في جميع أنحاء العالم وبشكل جماعي؛ لأنّ الإمام المظلوم كان يحارب الظلم والطغاة، فهو مخالف ليزيد وأمثال يزيد، حيث قال: «وعلى الإسلام السلام، إذ قد بُليت الأمّة براع مثل يزيد»[874]، وكلام الإمام× لم يكن مختصّاً بيزيد الرجس فحسب.
وجاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: «محقّق لما حقّقتم، مبطل لما أبطلتم»[875]، وهذا يعني أنّنا نحقّق كلّ ما حقّقه أهل البيت^ من معارف رفيعة، ونرى بطلان كلّ ما تبطلونه من أفكار وأعمال باطلة، وهذا يعني أنّنا سنبذل الجهود الحثيثة في رفض كلّ حكومة رفضتموها، ونسعى لتثبيت كلّ حكومة أسستم لها.
بالرغم من أنّ الأئمّة نور واحد، لكن زيارة الحسين× هي الأكثر ثواباً، فإنّ زيارته× ورد الحثّ والتأكيد عليها[876]، وإذا لم يتمكّن الإنسان من زيارة الإمام الحسين× عن قرب، فعليه بقراءة زيارة عاشوراء كي لا يمضي عليه يوم دون ذكر الإمام الحسين×، فعند الخروج من المنزل صباحاً يتوجّه الإنسان نحو القبلة، ويقول ثلاثاً: «السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته».
وقد اعتاد الكثير من العلماء إذا ما واجهوا مشكلة ما، فإنّهم ينذرون لله تعالى قراءة زيارة عاشوراء.
14ـ إنّ شهر محرّم الحرام هو الظرف الزماني الذي يُقام فيه العزاء على سيّد الشهداء×، وهو كشهر رمضان المبارك من جهتين:
أـ إنّ الرسول الأكرم’ قال بحقّ شهر رمضان: «أنفاسكم فيه تسبيح»[877]، وقد جاء بحقّ العزاء على سيّد الشهداء×: «نفس المهموم لظلمنا تسبيح، وهمّه لنا عبادة»[878].
ب ـ إنّنا نطلب من الله} في آخر شهر رمضان المبارك أن لا يجعله آخر العهد لصيامه، وإذا كان آخر العهد، فنسأله أن يجعلنا من المرحومين لا المحرومين، كما ورد: «اللهمّ لا تجعله آخر العهد من صيامنا أيّاه...، فإن جعلته فاجعلني مرحوماً، ولا تجعلني محروماً»[879]، فالأنسب في آخر شهر محرّم يقال أيضاً: اللهمّ لا تجعله آخر العهد لإقامتنا العزاء على سيّد الشهداء×، فإن جعلته فاجعلنا مرحومين ولا تجعلنا محرومين. آمين يا ربّ العالمين.
1. ابن أبي الحديد المعتزلي، عبد الحميد بن محمد المدائني (586ـ656)، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1404ق.
2. ابن أبي جمهور، محمد بن علي الأحسائي (840ـ بعد 901ق)،، عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة، تحقيق: الآقا مجتبى محمدي العراقي، قم، انتشارات سيّد الشهداء، 1405ق.
3. ابن إدريس الحلّي، محمد بن منصور (546ـ598)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410ق.
4. ابن أعثم الكوفي، أبو محمد أحمد (م314ق)، كتاب الفتوح، تحقيق: علي شيري، الطبعة الأولى بيروت، دار الأضواء، 1411ق.
5. ابن الأثير الجزري، على بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (555ـ630ق)، الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادرـ دار بيروت 1385ق/ 1965م.
6. ابن المشهدي، محمد بن جعفر المشهدي الحائري (م610ق)، المزار الكبير، تحقيق جواد القيّومي الإصفهاني، الطبعة الأولى، قم، مكتب النشر الإسلامي، 1419ق.
7. ابن حنبل، أحمد بن محمد (م 241ق)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت، دار صادر، (بلا تاريخ).
8. ابن سعد، محمد بن سعد الزهري البصري (168ـ 230ق)، الطبقات الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتاب العلمية، 1410ق/ 1990م.
9. ابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله (370ـ428ق)، الإشارات والتنبيهات، ، الطبعة الأولى، قم، نشر البلاغة، 1375ش.
10. ابن سينا، الشيخ الرئيس حسين بن عبد الله، (370ـ428)، رسائل ابن سينا، قم، بيدار، 1400ق.
11. ابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي (القرن 4 للهجرة)، تحف العقول عن آل الرسول^، تصحيح: علي أكبر غفّاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1404ق/ 1363ش.
12. ابن شهر آشوب، محمد بن علي المازندراني (489ـ588ق)، مناقب آل أبي طالب، تصحيح السيّد هاشم رسولي محلّاتي –محمد حسين دانش الأشتياني، قم العلّامة، 1379ق.
13. ابن طاووس، على بن موسى بن جعفر (589ـ664)، فلاح السائل ونجاح المسائل، قم مكتب النشر الإسلامي.
14. ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر (589ـ664ق)، الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة، طهران، دار الكتب الإسلاميّة، 1367ش.
15. ابن طاووس، علي بن موسى(ت664)، اللهوف في قتلى الطفوف، الطبعة الأولى،قم، أنوار الهدي، 1417 ق.
16. ابن عاشور، محمد بن طاهر التونسي (1296ـ1393ق)، التحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور التونسي)، مؤسسة التاريخ (بلا تاريخ).
17. ابن عربي الحاتمي الطائي، محيي الدين محمد بن علي (560ـ638ق)، الفتوحات المكّية، تحقيق: عثمان يحيى الطبعة الثانية، مصر، المجلس الثقافي في مصر، 1405ق.
18. ابن فتّال النيسابوري، محمد بن الحسن، (م508ق)، روضة الواعظين وتبصرة المتّعظين، تحقيق السيّد محمد مهدي الخرسان، قم، الشريف الرضي، (بلا تاريخ).
19. ابن فهد الحلّي، أحمد بن محمد (757ـ841)، عدّة الداعي ونجاح الساعي، تصحيح: أحمد الموحّدي القمّي، قم، دار الكتاب الإسلامي، 1407ق.
20. ابن قولويه القمّي، جعفر بن محمد (م367ق)، كامل الزيارات، النجف، انتشارات مرتضوية، 1356ش.
21. ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي الشافعي (701ـ774)، تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتاب العلميّةـ منشورات محمد علي بيضون، 1419.
22. ابن كثير، إسماعيل بن عمر الدمشقي الشافعي (701ـ774ق)، البداية والنهاية، بيروت، دار الفكر، 1407ق/ 1968م.
23. ابن منظور، محمد بن مكرم المصري (630ـ711ق)، لسان العرب، بيروت، دار صادر، 1414ق.
24. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد (567ـ645ق)، مثير الأحزان ومنير سبيل الأشجان، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي# الطبعة الثالثة، قم، مدرسة الإمام المهدي #، 1406ق.
25. ابن هلال الثقفي، إبراهيم بن محمد (حوالي 200ـ283)، الغارات أو الاستنفار والغارات، تحقيق: السيّد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، قم دار الكتاب الإسلامي، 1410ق.
26. أبو الفتح الكراجكي، محمد بن علي (م449ق)، كنز الفوائد، تحقيق: عبد الله نعمة، الطبعة الأولى، قم، دار الذخائر، 1410ق.
27. أبو الفرج الإصفهاني، على بن الحسين (284ـ362ق)، مقاتل الطالبيين، تحقيق: سيّد أحمد صقر، بيروت، دار المعرفة، (بلا تاريخ).
28. أبو مخنف الكوفي، لوط بن يحيى (158ق)، وقعة الطف، تحقيق: محمد هادي اليوسفي الغروي، الطبعة الثالثة، قم، جامعة المدرّسين، 1417ق.
29. أبو مخنف الكوفي، لوط بن يحيى (م158ق)، مقتل الحسين× (مقتل أبي مخنف)، تحقيق: حسين غفّاري، قم مطبعة العلميّة (بلا تاريخ).
30. الأربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح (م693ق)، كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، تصحيح: السيّد هاشم رسولي المحلّاتي، تبريز، مكتبة بني هاشمي، 1381ق.
31. إلهي قمشه أي، مهدي ، كلّيات ديوان حكيم إلهي قمشه أي، طهران، انتشارات علميّة إسلاميّة (بلا تاريخ).
32. الإمام الخميني، السيّد روح الله الموسوي (1281ـ1368ش)، تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس، الطبعة الثانية، 1410ق.
33. الإمام الخميني، السيّد روح الله بن مصطفى الموسوي& (1281ـ 1368ش)، صحيفة الإمام، مجموعة آثار الإمام الخميني&، الطبعة الرابعة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني& 1385ش.
34. الآملي، السيّد حيدر بن علي العبيدي الحسيني (حوالي720ـ794ق)، أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الطريقة، تصحيح: السيّد محسن الموسوي التبريزي، قم، نور علي نور، 1382ش.
35. الأمين العاملي، السيّد محسن، أعيان الشيعة بيروت، دار التعارف، (بلا تاريخ).
36. البحراني، السيّد هاشم بن سليمان الحسيني (م1107ق)، مدينة معاجر الأئمّة الاثني عشر، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة المعارف الإسلاميّة، 1413ق.
37. البحراني، عبد الله بن نور الله (القرن 12 هجري)، عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، تحقيق: السيّد محمد باقر الموحّدي الأبطحي الإصفهاني، الطبعة الأولى، قم مؤسسة الإمام المهدي#، 1413ق.
38. البحراني، يوسف بن أحمد (1192ـ1266ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق، محمد تقي الإيرواني ـ السيّد عبد الرزّاق المقرّم، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405ق.
39. البلخي المولوي، جلال الدين محمد بن محمد (604ـ672)، كلّيات ديوان شمس تبريزي، تصحيح: محمد عباسي، طهران، انتشارات طلوع. بلا تاريخ.
40. البهائي، بهاء الدين محمد بن حسين العاملي (953ـ1031ق)، كلّيات أشعار وآثار فارسي شيخ بهائي، تصحيح: غلام حسين الجواهري، الطبعة الثالثة، طهران، انتشارات مكتبة المحمودي، 1372ش.
41. البهبهاني، محمد باقر بن عبد الكريم (م1285ق)، الدمعة الساكبة في أحوال العترة الطاهرة، تحقيق: حسين الأعلمي، الطبعة الأولى، بيروت مؤسسة الأعلمي، 1409.
42. البيروني، أبو ريحان (440ق)، تحقيق ما للهند، ترجمة: منوجهري صدوقي سها، طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگی.
43. التبريزي، الميرزا محمد تقي حجة الإسلام (1248ـ1312ق)، ديوان نير التبريزي، الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة شمس الشموس الثقافية 1387ش.
44. الترمذي، حمد بن علي بن حسن (م360ق)، نوادر الأصول في أحاديث الرسول’، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، بيروت، دار الجيل، 1992م.
45. التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد (510ـ550ق)، غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق: مصطفى درايتي، قم مكتب النشر الإسلامي، 1366ش.
46. جرمرودي التبريزي، محمد رفيع (م1330)، ذريعة النجاة، تحقيق: محمد حسين رحيميان، الطبعة الأولى، دار الكتب الإسلاميّة، 1422ق.
47. جلال الدين المولوي، محمد بن محمد البلخي (604ـ672ق)، كتاب فيه ما فيه، تصحيح: بديع الزمان فروزان فر، الطبعة الثالثة عشرة، طهران، أمير كبير، 1389ش.
48. جلال الدين المولوي، محمد بن محمد البلخي (604ـ672ق)، مثنوي معنوي، على أساس نسخة رينولد نيكلسون، الطبعة الأولى، طهران، انتشارات راستين، 1375ش.
49. جوادي الآملي، عبد الله، شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسينی، قم، مركز نشر إسراء.
50. حافظ الشيرازي، شمس الدين محمد بن بهاء الدين (م792ق)، ديوان غزليات حافظ، تصحيح خليل خطيب رهبري، الطبعة الثالثة، طهران، مكتبة صفي علي شاه، 1365ش.
51. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله (321ـ405ق)، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت، دار المعرفة، (بلا تاريخ).
52. الحائري، محمد بن أبي طالب الحسيني (القرن10 الهجري)، تسلية المجالس وزينة المجالس (مقتل الحسين)، تحقيق: فارس حسّون كريم، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة المعارف الإسلاميّة 1418ق.
53. الحائري، محمد مهدي (م1344ق)، معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين÷، الطبعة الأولى، بيروت، البلاغ، 1423ق.
54. الحرّ العاملي، محمد بن حسن (1033ـ1104ق)، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق: مؤسسة آل البيت^، قم، مؤسسة آل البيت^، (1409ق).
55. الخزّاز القمّي، علي بن محمد (القرن4 هجري)، كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثنى عشر^، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري، قم بيدار، 1301ق.
56. الخصيبي، حسين بن حمدان (260ـ334ق)، الهداية الكبرى، بيروت، البلاغ، 1419ق.
57. الخواجوي الكرماني، محمود بن علي (689ـ752)، روضة الأنوار، تصحيح: محمود العابدي، الطبعة الأولى، طهران، ميراث مكتوب، 1387ش.
58. الخوارزمي، الموفّق بن أحمد الحنفي (484ـ567 او 568ق)، مقتل الحسين× (مقتل الخوارزمي)، تحقيق: محمد السماوي الطبعة الخامسة (بلا مكان)، أنوار الهدى، 1431.
59. خوشدل الطهراني، علي أكبر صلح خواه، ديوان خوشدل الطهراني، الطبعة الثانية، طهران نشريات ما، 1370، ش.
60. الدمشقي الحنبلي، ابن عادل، أبو حفص عمر بن علي (880ق)، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ـ علي محمد معوض، الطبعة الأولى، بيروت دار الكتب العلمية 1419ق.
61. دهخدا، علي أكبر (م 1334ق)، لغت نامة دهخدا، الطبعة الثانية طهران، مؤسسة طبع ونشر جامعة طهران، 1377ش.
62. دهخدا، علي أكبر (م1334)، أمثال وحكم، الطبعة الخامسة، طهران أمير كبير، 1361ش.
63. الديلمي، الحسن بن علي بن محمد (م841ق)، إرشاد القلوب إلى الصواب، الطبعة الأولى، قم، الشريف الرضي، 1412ق.
64. الذهبي، محمد بن أحمد شمس الدين (673ـ748ق)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تحقيق عمر عبد السلام التدمري، بيروت، دار الكتب العربي، 1413ق/ 1993م.
65. السبزواري، الملّا هادي بن محمد (1212ـ1289)، شرح المنظومة، تصحيح وتحقيق: حسن حسن زاده آملي – مسعود طالبي، الطبعة الأولى، طهران، نشر ناب، 1369ـ1379ش.
66. السبزواري، الملّا هادي بن محمد (ص1212ـ1289)، ديوان الحاج ملّا هادي السبزواري، طهران، انتشارات كتاب فروشي محمودي، بلا تاريخ.
67. السبزواري، الملّا هادي بن محمد، الحكيم (1212ـ1289ق)، أسرار الحكم في المفتتح والمختتم،، تصحيح: كريم فيضي، الطبعة الأولى، قم، المطبوعات الدينية، 1383ش.
68. سبط ابن الجوزي، يوسف بن قزاوغلي البغدادي، (581 أو 582ـ654)، تذكرة الخواص من الأمّة في ذكر خصائص الأئمّة، قم، الشريف الرضي، 1418ق.
69. سعادت برور، علي (1305ـ1383ش)، جمال افتاب وافتاب هر نظر، الطبعة الثالثة، طهران انتشارات إحياء كتاب، 1382ش.
70. سعدي الشيرازي، مصلح الدين مفلح بن عبد الله (606ـ691 او695ق)، كلّيات سعدي، تصحيح: محمد علي فروغي، الطبعة الثانية، طهران، انتشارات ميلاد، 1380ش.
71. السنائي الغزنوي، أبو المجد مجدود بن آدم (473ـ525ق)، ديوان الحكيم السنائي، تحقيق مظاهر مصفا، طهران، أمير كبير، 1336 ش.
72. الشاذلي، سيّد قطب بن إبراهيم (1324ـ 1387ق)، في ظلال القرآن، الطبعة السابعة، بيروت ـ القاهرة، دار الشروق، 1412ق.
73. الشريف الرضي، محمد بن حسين بن موسى (359ـ406ق)، نهج البلاغة، تصحيح: صبحي الصالح، قم دار الهجرة، بلا تاريخ.
74. الشوشتري الشهيد الثالث، القاضي السيّد نور الله بن السيّد شريف الدين (1019ـ956)،إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل، قم، مكتبة آية الله المرعشي النجفي 1409.
75. شيخ الإشراق السهروردي، يحيى بن حبش (549ـ587ق)، مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق، تصحيح: هانري كربن ـ السيّد حسين نصر – نجف قلي حبيبي، طهران، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگی، 1375.
76. الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (942ق)، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، على محمد، معوض، بيروت، دار الكتب العلميّة، 1414ق/1993م.
77. صحيفة الإمام الرضا×، منسوبة إلى الإمام الرضا× (148ـ203)، تحقيق: محمد مهدي نجف، الطبعة الأولى، مشهد، مؤتمر الإمام الرضا× 1406ق.
78. الصحيفة السجّاديّة، الإمام علي بن الحسين السجّاد× (38ـ94ق)، الطبعة الأولى، قم نشر الهادي، 1376ش.
79. صدر الدين القونوي، محمد بن إسحاق (م672ق)، شرح الأربعين حديثاً، تحقيق: حسن كامل ييلماز، قم، انتشارات بيدار، 1372ش.
80. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي (305ـ381ق)، الأمالي، ترجمة: محمد باقر الكمره اي، طهران المكتبة الإسلاميّة، 1362ش.
81. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي (305ـ381ق)، التوحيد، تصحيح: السيّد هاشم الحسيني الطهراني، الطبعة الثانية، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1398ق/ 1357ش.
82. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي (305ـ381ق)، عيون أخبار الرضا×، تصحيح: السدي مهدي الحسيني اللاجوردي، طهران، جهان، 1378ق.
83. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي (305ـ381ق)، معاني الأخبار، ترجمة: موسوي الدامغاني، الطبعة الثانية، قم، تابان، 1379ش.
84. الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي (305ـ381ق)، من لا يحضره الفقيه، تصحيح: علي أكبر غفّاري، الطبعة الثالثة، قم مؤسسة النشر الإسلامي، 1413.
85. الصفار، محمد بن حسن بن فروخ القمّي (م290ق)، بصائر الدرجات في فضائل آل محمد^، تصحيح: الميرزا محسن كوجه باقي التبريزي، الطبعة الثانية، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1404ق.
86. الطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب (م588ق)، الاحتجاج، تحقيق: السيّد محمد باقر الموسوي الخرسان، مشهد، نشر مرتضى، 1403ق.
87. الطبرسي، الفضل بن حسين، أمين الإسلام (470ـ548)، إعلام الورى بأعلام الهدى، قم، دار الكتب الإسلامية، (بلا تاريخ).
88. الطبرسي، فضل بن الحسن (468ـ548)، مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: محمد جواد البلاغي، الطبعة الثالثة، طهران، ناصر خسرو، 1372ش.
89. الطبري، محمد بن جرير بن يزيد (224ـ310ق)، تاريخ الأمم والملوك (تاريخ الطبري)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، بيروت، دار التراث، 1387ق/ 1967م.
90. الطريحي، فخر الدين بن محمد علي (979ـ1087ق)، المنتخب في جمع المراثي والخطب، المشتهر بالفخري، الطبعة الأولى، المكتبة الحيدرية، 1426ق.
91. الطريحي، فخر الدين بن محمد علي (979ـ1087ق)، مجمع البحرين، تصحيح: السيّد أحمد الحسيني الطهراني، مكتبة مرتضوي، 1416ق/ 1375ش.
92. الطوسي، محمد بن الحسن (385ـ460ق)، الأمالي، قم، دار الثقافة، 1414ق.
93. الطوسي، محمد بن الحسن (385-460ق)، مصباح المتهجد، تصحيح وتحقيق: علي أصغر مراوريد ـ أبو ذر بيدار، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، 1411ق.
94. الطوسي، محمد بن حسن (385ـ460ق)، تهذيب الأحكام، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران دار الكتب الإسلاميّة، 1365ش.
95. العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف بن المطهّر (648ـ726ق)، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تصحيح: حسن زاده الآملي، الطبعة الرابعة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413ق.
96. العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف بن المطهّر (648ـ726ق)، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، تحقيق: مؤسسة الأبحاث الإسلاميّة، الطبعة الأولى، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1412ق.
97. العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف بن المطهّر (648ـ726ق)، نهج الحقّ وكشف الصدق، تصحيح: عين الله حسنى الأرموي، قم، دار الهجرة، 1407ق.
98. العلّامة الطباطبائي، السيّد محمد حسين (1321ـ1402ق)، الميزان في تفسير القرآن، قم، مكتب النشر الإسلامي، 1417ق.
99. العياشي، محمد بن مسعود بن عيّاش السلمي (م320ق)، تفسير العيّاشي، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي، طهران المطبعة العلمية، 1380ق.
100. غضنفري، كامران، أمريكا وبراندازي جمهوري إسلامي ايران، طهران، انتشارات كيا، (بلا تاريخ).
101. الفاضل الدربندي، آغا ابن عابد الشيرواني الحائري (م1285ق)، إكسير العبادات في أسرار الشهادات، تحقيق: محمد جمعة بادي ـ عباس الملّا عطيّة الجمري، الطبعة الأولى، المنامة، شركة المصطفى، 1415ق.
102. الفخر الرازي، محمد بن عمر بن حسين (544ـ606ق)، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420ق.
103. القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري (578ـ668ق)، الجامع لأحكام القرآن، الطبعة الأولى، طهران، ناصر خسرو، 1382ش.
104. القطب الراوندي، سعيد بن عبد الله (م573ق)، الخرائج والجرائح، تحقيق: السيّد محمد باقر الموحّد الأبطحي، الطبعة الأولى، قم، مؤسسة الإمام المهدي#، (1409ق).
105. القطب الراوندي، سعيد بن عبد الله (م573ق)، فقه القرآن في شرح آيات الأحكام، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، الطبعة الثانية، قم مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1405ق.
106. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم الحسيني (1220ـ1294ق)، ينابيع المودّة لذوي القربى، تحقيق: السيد علي جمال أشرف الحسيني، طهران، أسوة، 1416ق.
107. الكاشاني، كمال الدين عبد الرزّاق، تأويلات مولى عبد الرزّاق الكاشاني (تفسير ابن عربي)، تحقيق: سمير مصطفى رباب، الطبعة الأولى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1422ق.
108. كاشف الغطاء، جعفر بن خضر النجفي (1154ـ1228ق)، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، الطبعة الأولى، قم، مكتب التبليغ الإسلامي، 1422ق (الطبعة الجديدة).
109. الكتاب المقدّس، (عهد عتيق وعهد جديد)، المترجم، رابطة كتاب إيران المقدّس، الطبعة الثانية، إيران، رابطة كتاب إيران المقدّس، 1987م.
110. الكفعمي، إبراهيم بن علي العاملي (840ـ905)، البلد الأمين والدرّ الحصين، الطبعة الحجريّة (بلا تاريخ).
111. الكفعمي، إبراهيم بن علي العاملي (840ـ905ق)، مصباح الكفعمي أو جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية، قم رضى (زاهدي)، 1405ق.
112. الكليني، محمد بن يعقوب الرازي (م329ق)، الكافي، طهران، دار الكتب الإسلاميّة 1365ش.
113. المالكي الأشتري، ورّام بن أبي فراس (م 605ق)، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، (مجموعة ورّام)، تحقيق: على أصغر حامد، قم، مكتبة الفقيه (بلا تاريخ).
114. المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي (1037ـ1110ق)، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق.
115. مجموعة من المؤرخين، مهدي بيشوائي، تاريخ قيام ومقتل جامع سيّد الشهداء×، الطبعة الرابعة، قم، مؤسسة الإمام الخميني&للتعليم والأبحاث، 1391ش.
116. المحتشم الكاشاني، علي بن أحمد (م996ق)، ديوان مولانا محتشم الكاشاني، بالاستعانة بـ: مهرعلي الجرجاني، الطبعة الأولى، طهران، السنائي، 1387ش.
117. المحدّث القمّي، عباس بن محمد رضا (1294ـ1359ق)، الكنى والألقاب، طهران، مكتبة الصدر (بلا تاريخ).
118. المحدّث القمّي، عباس بن محمد رضا (1294ـ1359ق)، نفس المهموم، لم يذكر محل الطبع والناشر وتاريخ الطبع.
119. المحدّث النوري، الميرزا حسين الطبرسي (1254ـ1320ق)، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تحقيق: مؤسسة آل البيت×، الطبعة الأولى، قم مؤسسة آل البيت×، 1408ق/1987م.
120. المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن الهذلي (602ـ676ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تعليق وتحقيق: عبد الحسين محمد علي البقال، قم، إسماعيليان، 1408ق.
121. المصطفوي، العلّامة حسن (1297ـ1384ش)، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، طهران بنكاه ترجمة، ونشر كتاب، 1402ق/ 1360ش.
122. المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري (336ـ413)، الأمالي، الطبعة الثانية، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 1413.
123. المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري (336ـ413)، الاختصاص، تصحيح: على أكبر غفّاري، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 1413ق.
124. المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري(336ـ413)، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، تحقيق: مؤسسة آل البيت^، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 1413 ق.
125. المفيد، محمد بن محمد بن نعمان العكبري (336ـ381ق)، المقنعة، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 1413ق.
126. المفيد، محمد بن محمد بن نعمان العكبري (336ـ413ق)، كتاب المزارـ مناسك المزار، تحقيق: السيّد محمد باقر الموحّد الأبطحي، الطبعة الأولى، قم، مؤتمر الشيخ المفيد، 1413ق.
127. المفيد، محمد بن محمد بن نعمان العكبري (336ـ413ق)، مسارّ الشيعة، الطبعة الثانية، بيروت، دار المفيد، 1414ق.
128. المقرّم، السيّد عبد الرزّاق الموسوي (م1971م)، مقتل الحسين×، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة النور، 1423ق.
129. من علماء البحرين والقطيف، وفيات الأئمّة، الطبعة الأولى، بيروت، دار البلاغة، 1412ق.
130. النجفي، محمد حسن، صاحب الجواهر، (1192ـ1266ق)، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق: عباس القوجاني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (بلا تاريخ).
131. نظامي الگنجوي، إلياس بن يوسف، (530ـ614ق)، كلّيات حكيم نظامي گنجوي، الطبعة الأولى، طهران، بهزاد، 1378ش.
132. نظامي گنجوي، إلياس بن يوسف (530ـ614ق)، ليلى ومجنون، تصحيح: بهروز ثروتيان، الطبعة الثانية، طهران، انتشارات راستين، 1375ش.
[1] البقرة: آية31.
[2] المجادلة: آية11.
[3] البقرة: آية129.
[4] آل عمران: آية164.
[5] الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
[6] البقرة: آية253.
[7] الخميني، روح الله، أسرار الحكم: ص104.
[8] السبزواري، ملّا هادي، تعليقات على شرح فصوص الحكم: ص116.
[9] الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص245ـ246.
[10] الحجّ: آية52.
[11] فصّلت: آية44.
[12] الشمس: آية8.
[13] الأعراف: آية12، ص: آية76.
[14] ق: آية30.
[15] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة، الحكمة: 211.
[16] الأنعام: آية162.
[17] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الكتاب45.
[18] ديوان نيِّر التبريزي، ص261. مضمون هذه الأبيات كالتالي: أيّتها النفحات القدسيّة، مرّي على بقعة مباركة فيها تخشع القلوب، بقعة إن مرّ بها الخليل إبراهيم لارتجفت يده، وإن وقف عليها الذبيح إسماعيل لارتجف قلبه، ولو مرّ بها المسيح عيسى لارتجفت شفته، ولو مرّ عليها الكليم لارتجفت رجليه، ثمّ اخلع نعليك، وقف بجانب الطور الأيمن، واعلم لو نودي في تلك البقعة (لن تراني) لصعق فيها ألف موسى.
[19] الأعراف: آية143.
[20] الكفعمي، إبراهيم، البلد الأمين: ص188، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: دعاء كميل.
[21] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج1، ص426، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: القسم الأوّل الأدعية.
[22] الإسراء: آية55.
[23] البقرة: آية253.
[24] الصحيفة السجّاديّة: الدعاء13.
[25] المولوي، جلال الدين، مثنوي معنوي، الكرّاس الثالث: ص528، البيت 4727.
[26] البقرة: آية31.
[27] البقرة: آية31.
[28] البقرة: آية32.
[29] البقرة: آية33.
[30] الصحيفة السجّادية: الدعاء47.
[31] النازعات: آية5.
[32] وهذا العلم لا يحتاج إلى واسطة، فإنّ (لدن) تعني تلقّي العلم من الله مباشرة، ومن دون توسّط أحد في حرم الغيب.
[33] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص83.
[34] ابن سينا، حسين بن عبد الله، الإشارات والتنبيهات: ص147.
[35] عشق آينه بلند نوراست شهوت ز حساب عشق دور است.
نظامي كنجوي، إلياس بن يوسف، ليلى ومجنون: ص321، البيت197. مضمون البيت: العشق مرآة راقية عاكسة للنور، والشهوة أجنبيّة عن العشق.
[36] المفيد، محمد بن محمد، الاختصاص: ص6، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج34، ص274.
[37] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الكتاب45.
[38]الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الخطبة 26، راجع: خطبة217.
[39] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص94.
[40] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص492.
[41] شاه نيمروز: كناية عن الشمس عند اشتداد سطوعها.
[42] سجنجل: المرآة في اللفظ الرومي.(لغت نامه دهخدا، ج9، ص13487).
[43] (السندروس)السندلوس: مادّة صمغية صفراء تخرج من أشجار خاصّة في أفريقيا، وتطلق على نوع من الأحجار الكريمة.( لغت نامه دهخدا، ج9، ص13788).
[44] نير تبريزي، محمد تقي، ديوان نير تبريزي: منظومة لئالي، مرثية1، مقطع6، ص197ـ 198. ومضمون الأبيات: يصف الشاعر وقوف الإمام الحسين× يوم عاشوراء أمام جيش العدو كالشمس الطالعة وهو يناديهم ويبيّن مكانته عند الله وعند الأنبياء ويذكر لهم أنّهم لم يطلب سلطاناً لا في الحجاز ولا في العراق ولا في الشام ولا في خراسان، وإنّما هو مسلم للعهد الذي عاهد الله عليه منذ الأزل واشتاقت نفسه إلى لقاء الله عزّ وجلّ.
[45] الحجّ: آية37.
[46] فاطر: آية10.
[47] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص723، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص201.
[48] الأعراف: آية58.
[49] آل عمران: آية196ـ 170.
[50] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص723، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص201.
[51] يس: آية 26ـ 27.
[52] الأنبياء: آية26ـ 27.
[53] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص237، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص184.
[54] الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج3، ص518، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: الزيارة المطلقة الأولى للإمام الحسين×.
[55] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص574، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: الزيارة المطلقة الخامسة والسادسة لأبي عبد الله×.
[56] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص213، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص167.
[57] الأنعام: آية90.
[58] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص176. القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: زيارة عاشوراء.
[59] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص256، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: زيارة العباس بن علي×: «سلام الله وسلام ملائكته المقرّبين، وأنبيائه المرسلين، وعباده الصالحين، وجميع الشهداء والصدّيقين، والزاكيات الطيّبات فيما تغتدي وتروح، عليك يا بن أمير المؤمنين، أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل، والسبط المنتجَب، والدليل العالم، والوصي المبلّغ، والمظلوم المهتضَم».
[60] الصافات: آية109ـ 110.
[61] الصافات: آية120ـ 121.
[62] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص176، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: زيارة عاشوراء.
[63] الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج2، ص614، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: زيارة الجامعة الكبيرة.
[64] نفس المصدر.
[65] الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات: ج1، ص21، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج2، ص191.
[66] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص175، الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص269.
[67] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج2، 85، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج16، ص95.
[68] أبيات شعر مستلَّة من روضة الأنوار للخواجوي الكرماني. مضمون الآبیات: السلوك إلى الله عزّ وجلّ والحالات المعنوية لا يمكن إدراكها بالأمور المادّية، فالمعاني الغيبة لا يدركها إلّا أهل الغيب، وأشار إلى أنّ الشهداء أحياء يناجون معشوقهم خالدون عند ربّهم مبيّناً: أنّ مائدة أصحاب القلوب الحيّة حِكمة وفائدة، ومائدة أصحاب القلوب الميّتة طعام.
[69] العلق: آية4.
[70] العلق: آية5.
[71] فصّلت: آية21.
[72] ديوان حكيم سنائي غزنوي، ص657. مضمون البيت: يشير الشاعر إلى أنّه لا ينبغي للإنسان أن يقول أمام ساحة الباري عزّ وجلّ: إنّي بذلت هذه الجهود والابتكارات وأقدّمها إلى الله جلّ وعلا، بل ينبغي أن يقدّم ما عنده بوجه مغبر عامل كادح لله عزّ وجلّ، ولو قدّم ما عنده بعنوان أنّها جهوده وابتكارته فقد فضح نفسه؛ لأنّ الله تعالى هو الذي وهبه كلّ ذلك فكيف يقدّمه له.
[73] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الحكمة303.
[74] حافظ الشيرازي، محمد، ديوان غزليات حافظ: غزل11، ص17.
[75] البقرة: آية154.
[76] آل عمران: آية169ـ 170.
[77] الإسراء: آية70.
[78] ص: آية75.
[79] عبس: آية15ـ 16.
[80] الأنبياء: آية26ـ 27.
[81] الإسراء: آية70.
[82] البقرة: آية30.
[83] طه: آية25.
[84] القصص: آية25.
[85]طه: آية32.
[86] طه: آية43.
[87] طه: آية43.
[88] الحجّ: آية8ـ9.
[89] الحجّ: آية3.
[90] إبراهيم: آية51.
[91] البقرة: آية130.
[92] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص85، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج16، ص95.
[93] طه: آية44.
[94] الأعراف: آية117. (وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ).
[95] الحديد: آية25.
[96] إبراهيم: آية19.
[97] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الكتاب47.
[98] نفس المصدر: الخطبة27.
[99] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج2، ص118.
[100] التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم: ص119.
[101] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة193.
[102] سعادت برور، علي، جمال آفتاب: ج5، غزل243، ص37. مضمون البيت: لا يعلم أحد أين المنزل المقصود وأين موضعه ومكانه لكن يسمع رنين جرسه.
[103] النساء: آية72.
[104] اُنظر: جوادي الآملي، عبد الله، شكوفائي عقل در پرتوی نهضت حسيني، ص83ـ93.
[105] المفيد، محمد بن محمد، الاختصاص: ص13، الصالحي الشامي، محمد بن يوسف، سبل الهدى: ج11، ص7، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج65، ص45. جدير بالذكر أنّ هذه الجملة قد وردت عن رسول الله’ وعن أمير المؤمنين× وعن الإمام الصادق×.
[106] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة2، الفقرة12.
[107] نفس المصدر: خطبة3.
[108] نفس المصدر: خطبة189.
[109] الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج2، ص613، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: زيارة الجامعة الكبيرة.
[110] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة 192، 122.
[111] نفس المصدر: الحكمة111.
[112] نفس المصدر، شرح السيد الرضي ذيل الحكمة المذكورة.
[113] الحشر: آية21.
[114] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الحكمة111.
[115] المائدة: آية55.
[116] المائدة: آية3.
[117] المائدة: آية67.
[118] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص101، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص12.
[119] ثالث ثلاثة كفر، وأمّا رابع ثلاثة وسادس خمسة توحيد خالص. وثالث ثلاثة تعني أنّ هذه الذوات الثلاثة بأيّ واحدة منها بدأت فالثالث هو الله}، فالمسيح وروح القدس والله، ثلاث ذوات في عرض واحد، ولكنّ الله تعالى ليس ثالث ثلاثة. نعم، قد يكون رابع ثلاثة: (مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ...) (المجادلة: آية7) وهذا يعني أنّه إذا اجتمع ثلاثة في مكان ما، فالله تعالى هو رابع أولئك الثلاثة، وليس رابع أربعة، فكلّما عددتهم تجدهم ثلاثة، ولكنّ هناك رابع وهو الله مع الأوّل منهم ومع الثاني منهم ومع الثالث منهم، وقد ملأ المسافة بين الأوّل والثاني، والمسافة بين الثاني والثالث، والمسافة بين الأوّل والثالث، وقد أحاط بظاهرهم وباطنهم ولم يتوقّف عند هذا الحد. فهذا هو معنى رابع ثلاثة، وخامس أربعة، وسادس خمسة، ولا يمكن عدّه أبداً، وهذا هو التوحيد.
[120] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص561، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج65، ص45، ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج20، ص221. وقال الخواجة نصير الدين الطوسي&: «ومحاربو علي كفرة، ومخالفوه فسقة (نصير الدين الطوسي، محمد بن الحسن، كشف المراد: ص540)؛ إذن: فمخالف الإمام علي× مسلم فاسق، ومحاربه كافر، ولا يرى الجنّة؛ وذلك لقول رسول الله’: «حربك حربي، وسلمك سلمي».
[121] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص116، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص46.
[122] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص277.
[123] البقرة: آية124.
[124] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة205، ص322، «والله ما كانتْ لِي فِي الْخلافَة رغْبَة، ولَا فِي الْوِلَايَة إِرْبَة، ولكِنَّكُم دعَوْتُمُونِي إِلَيها وحَمَلْتُمُونِي عليْها».
[125] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص39، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص334. «أمّا بعد، فإنّ هانئاً وسعيداً قدما عليّ بكتبكم، وكانا آخر من قدم عليّ مِن رسلكم، وقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلّكم أنّه ليس علينا إمام، فأقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ والهدى، وأنا باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فإن كتب إليّ بأنّه قد اجتمع رأي ملئكم، وذوي الحجى والفضل منكم، على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإنّي أقدم إليكم وشيكاً _إن شاء الله_ فلعمري ما الإمام إلّا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بدين الحقّ، الحابس نفسه على ذلك لله، والسلام».
[126] الرعد: آية36.
[127] المائدة: آية3. (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا).
[128] الكليني، محمد بن محمد، الكافي: ج8، ص58.
[129] المائدة: آية3.
[130] المائدة: آية3.
[131] المائدة: آية3.
[132] طه: آية64.
[133] المفيد، محمد بن محمد، الاختصاص: ص139، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج33، ص291.
[134] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص53، ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص46.
[135] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص307، ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص181.
[136] أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف: ص172، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري: ج5، ص403.
[137] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص72، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص48.
[138] ابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي، تحف العقول: ص245، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج75، ص116.
[139] سبأ: آية28.
[140] الأنبياء: آية107.
[141] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص85، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج16، ص95.
[142] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج1، ص260، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج10، ص123.
[143] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص45 و525، ابن إدريس الحلّي، محمد بن منصور، السرائر: ج3، ض564.
[144] آل عمران: آية68.
[145] إبراهيم: آية36.
[146] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص45. ونصّ الرواية كالتالي: عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله×: يا بن يزيد، أنت _والله_ منّا أهل البيت، قلت: جعلت فداك، مِن آل محمد؟ قال: إي _والله_ مِن أنفسهم، قلت: مِن أنفسهم، جعلت فداك؟ قال: أي _والله_ من أنفسهم؟ يا عمر، أما تقرأ كتاب الله}: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ) وما تقرأ قول الله: (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
[147] الحجّ: آية78.
[148] الطبرسي، فضل بن الحسن، مجمع البيان: ج7، ص153. وعبارة تفسير مجمع البيان كالتالي: (ملّة أبيكم): «منصوبة بإضمار فعل تقديره: واتّبعوا والزموا ملّة أبيكم»، ص172.
[149] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص720، ابن طاووس، علي بن موسى، الإقبال بالأعمال الحسنة: ج2، ص571.
[150] الورثة ثلاث طبقات، والميراث عدّة أسهم، فالسهم الأكثر هو للطبقة الأولى، والسهم الأقل للطبقات المتأخّرة.
[151] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص79، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص381.
[152] الحجّ: آية62.
[153] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص79، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص381.
[154] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص788، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: زيارة الأربعين.
[155] البيت منسوب لمولوي، ويشير إلى أنّ روح الإنسان من عالم الملكوت لا من عالم الملك، وقد جعل البدن قفصاً لها لتمكث فيه أياماً.
[156] اُنظر: حافظ الشيرازي، محمد، ديوان غزليات حافظ: غزل351، 477. ومضمون البيت: روحي عارية أودعها عندي الحبيب، ويأتي يوماً أرى ضياءه وأستسلم له. يشير الشاعر إلى أنّ روحه أمانة من الله عزّ وجلّ وسترجع يوماً ما إلىه.
[157] آل عمران: آية106.
[158] الصف: آية10.
[159] وفي بعض النسخ (هشيم).
[160] اُنظر: جلال الدين المولوي، محمد بن محمد، مثنوي معنوي، الكرّاس الثالث: ص372، البيت1019. مضمون البيت: يشير الشاعر إلى أنّ الكائنات تقول بلسان الحال: إنّنا سميعون وبصيرون وسعداء، ولكننا لا نتمكّن من الحديث معكم؛ لأنّكم غير عالمنا.
[161] اُنظر: السبزواري، ملّا هادي، ديوان ملّا هادي السبزواري: ص29.
مضمون البيت: يشير الشاعر إلى حقيقة وهي أنّ كلّ ما في الكون يسبّح ويناجي الله عزّ وجلّ ولكن لا يوجد مثل موسى كي يسمع هذه المناجاة.
[162] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص79، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص381.
[163] القصص: آية81.
[164] طه: آية78.
[165] كان الاتّحاد السوفيتي الاشتراكي يمثّل قسماً كبيراً من خارطة العالم، فهؤلاء قد ارتكبوا للحفاظ على نظامهم جرائم قتل لم تخطر على بال أحد، فهؤلاء كانوا يعيشون في (الكرملين) بكامل الأمن والرفاهية، ولكن بإرادة الله سبحانه قد أُبيد نظامهم، وانهار انهياراً كأنّما لم يكونوامن قبل، كما جاء في القرآن الكريم: (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) (يونس: آية24). نعم، إنّ الله الواحد القهّار قد أباد قبلهم سلسلة من الملوك والسلاطين الذين حكموا عدّة قرون، وكأن لم يحكموا من قبل.
إنّ السلسلة البهلويّة قد ظلموا الشعب الإيراني لأكثر من خمسين سنة، وقد ابتدعوا في الدين كثيراً، فقد هدّموا المساجد، وتصرّفوا بالأوقاف، وفرضوا السفور، ومنعوا رجال الدين من ارتداء العمائم، وحظروا إقامة المجالس والعزاء على سيّد الشهداء×، ولكنّ الله قد طوى سجلّ هؤلاء طويةً كأنّما لم يلبثوا على الأرض إلّا خمسين ثانية.
[166] الفتح: آية4.
[167] المدّثر: آية31.
[168] الحجّ: آية62.
[169] الأنفال: آية29.
[170] البقرة: آية282.
[171] وهي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).
[172] الفتح: آية21.
[173] الأحزاب: آية40.
[174] الشمس: آية8.
[175] الشعراء: آية212.
[176] الحجّ: آية46.
[177] المطفّفين: آية15.
[178] الزخرف: آية77.
[179] ابن شعبة الحرّاني، الحسن بن علي، تحف العقول: ص245، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج75، ص117.
[180] الديلمي، الحسن بن علي، إرشاد القلوب: ج1، ص184؛ النوري الطبرسي، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل: ج1، ص368.
[181] الواقعة: آية79.
[182] الشعراء: آية227.
[183] الرعد: آية36.
[184] المؤمنون: آية44.
[185] نوح: آية17.
[186] المائدة: آية64.
[187] إبراهيم: آية24.
[188] الصف: آية8.
[189] التوبة: آية32.
[190] سبأ: آية19.
[191] المؤمنون: آية44.
[192] القصص: آية51.
[193] البقرة: آية246.
[194] اُنظر: البقرة: الآيات247ـ251.
[195] البقرة: آية247.
[196] الأعراف: آية12.
[197] البقرة: آية249.
[198] البقرة: آية249.
[199] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص100، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص5.
[200] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص100، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص5ـ6.
[201] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص9، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص8.
[202] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص19.
[203] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص18، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص19.
[204] الكافرون: آية6.
[205] أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف: ص154، ابن نما الحلّ، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص39، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص369.
[206] أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف، ص154، ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص39، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص369.
[207] إبراهيم: آية1.
[208] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة193.
[209] القطب الراوندي، سعيد بن عبد الله، الخرائج والجرائح: ج2، ص847ـ848، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص298.
[210] اُنظر: السعدي، مصلح الدين، كلّيات سعدي: ص331. مضمون البيت: إن كنت قصيراً لا تحاول أن تجعل نفسك طويلاً باستخدامك سیقان خشبیة لکی تکون فی أعین الأطفال أطول منهم.
[211] غافر: آية15.
[212] النور: آية36.
[213] مريم: آية57.
[214] البقرة: آية188.
[215] وبطبيعة الحال أنّ القرآن الكريم يحافظ على الأدب، وليس غرضه تحقير الأشخاص، فحينما يصف حقيقة الرشوة بهذا الوصف، فهو يبيّن الحقيقة لا أكثر، كما وصفها أمير المؤمنين×: «كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا» نهج البلاغة: خطبة224. وهذا يعني أنّ الرشوة تنغمس في مكان السم مرّتين: عند دخولها إلى من فم الأفعى، وعندما تخرج من فمها بواسطة القيء، ويوم القيامة تظهر هذه الحقيقة المرّة.
[216] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص60، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص367.
[217] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص183، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص134.
[218] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج1، ص307. الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج27، 92.
[219] غافر: آية26.
[220] الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص289، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج6، ص154، ج44، ص297.
[221] الأعراف: آية179.
[222] البقرة: آية130.
[223] الكهف: آية104.
[224] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص420، ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد بن حنبل: ج1، ص119.
[225] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج8، ص58، الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص67.
[226] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص34.
[227] البقرة: آية33.
[228] الآملي، حيدر بن علي، أنوار الحقيقة، وأطوار الطريقة: ص719ـ 731، ابن عربي، محيي الدين، الفتوحات المكّية: ج3، ص477.
[229] جلال الدين المولوي، محمد بن محمد، كلّيات شمس تبريزي: ص166، شماره441. لم يذكر صدر هذا البيت ومضمون ما ذكر: إن ما لا ينال أمنية.
[230] محمد: آية7.
[231] الأنعام: آية6.
[232] ما أكثر الناس الذين انزلقوا بسبب غفلة، وخسروا جميع ثمارهم التي حصلوا عليها بعد سنين متطاولة، ويشير إلى هذه الحقيقة العبارة الواردة في دعاء كميل: «كم من عثار وقيته»، (الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص845)، ولذا يستحبّ أن يُقرأ أثناء الوضوء عند مسح القدمين: «اللهمّ ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام» (الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج1، ص43)، (ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص53)، «ثبّت قدمي على الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام» (الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص71) (المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج77، ص320) ومعنى المسح على الرأس: امسح من ذهني كلّ باطل كي أتحدّث معك بذهن صافي. وهناك أسرار لغسل اليدين وبقيّة الأعضاء مذكورة في (الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج2، ص202)، (الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج1، ص393).
[233] الحجّ: آية40.
[234] الصف: آية14.
[235] البقرة: آية183.
[236] اُنظر: الخميني، روح الله، صحيفة الإمام&: ج21، ص278.
[237] الصف: آية14.
[238] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص116.
[239] يوسف: آية106.
[240] العيّاشي، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج2، ص200، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج68، 150ـ 151، ج69، ص99.
[241] الحديد: آية3.
[242] الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج4، ص380، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج16، ص313.
[243] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص24، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج16، ص313.
[244] وعلى حدّ تعبير صدر الدين القونوي، كلّ من أذنب فهو يدّعي الربوبيّة، وهو فرعون باطني، (اُنظر: القونوي، محمد بن إسحاق، شرح الأربعين حديثاً: ص78) وذلك لأنّ هذا الذنب إن كان قد صدر سهواً أو نسياناً أو اضطراراً أو إجباراً أو إكراهاً، فهو مرفوع بناء على حديث الرفع، ولا يعدّ ذنباً، وأمّا إذا صدر الذنب عن علم وعمد فهذا يعني: يا إلهي، أنّي أعلم بحكمك وقانونك، ولكن في حدود فهمي أنّ هذا العمل لا بدّ أن يتمّ إجراؤه. وهذا يعني الشرك، بالرغم من أنّ الله تعالى قد يعفو عن هذا الذنب بلطفه. نعم، إذا تكرّر الذنب فيمكن أن تجرّ هذه الذنوب القابلة للغفران إلى الشرك والتكذيب، ولذا قال الله تعالى: (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ) (الروم: آية10).
[245] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: حكمة374.
[246] نفس المصدر: كتاب47.
[247] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة192.
[248] المالكي، ورّام ابن أبي فراس، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج2، ص294، الترمذي، محمد بن علي، نوادر الأصول في أحاديث الرسول’: ج2، ص243.
[249] لقمان: آية17.
[250] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج58، ص129، ابن عادل الدمشقي، عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب: ج7، ص39.
[251] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة156.
[252] العلق: آية5.
[253] السجدة: آية4.
[254] الفرقان: آية31.
[255] النحل: آية90.
[256] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: حكمة374.
[257] الشريف الرضي، محمد الحسين، نهج البلاغة: حكمة374. والنص كالتالي: «فمِنهُم الْمُنكِر لِلمُنْكَرِ بِيَدِه ولِسَانِه وقَلْبِه ـ فذَلِك الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ ـ ومِنْهُم الْمُنْكِر بِلِسَانِه وقَلْبِه والتَّارِكُ بِيَدِه ـ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِن خِصَالِ الْخَيْرِ ـ ومُضَيِّعٌ خَصْلَةً ـ ومِنْهُم الْمُنْكِر بِقَلْبِه والتَّارِكُ بِيَدِه ولِسَانِه ـ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّع أَشْرَف الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ ـ وتَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ ـ ومِنْهُمْ تَارِكٌ لإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِه وقَلْبِه ويَدِه ـ فَذَلِكَ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ ـ ومَا أَعْمالُ الْبِرِّ كُلُّها والْجِهاد فِي سَبِيلِ الله ـ عِنْد الأَمرِ بِالْمَعْرُوف والنَّهيِ عَنْ الْمُنْكَرِ ـ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ».
[258] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص79، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص381.
[259] طه: آية44.
[260] القصص: آية40.
[261] الحديد: آية25.
[262] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص89.
[263] الأعراف: آية170.
[264] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص89. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329.
[265] هود: آية56.
[266] إبراهيم: آية1.
[267] الحديد: آية25.
[268] الطور: آية23.
[269] الأعراف: آية43.
[270] القصص: آية40.
[271] طه: آية78.
[272] طه: آية97.
[273] العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، نهج الحقّ وكشف الصدق: ص472، ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن علي، عوالي اللآلي: ج1، ص215.
[274] العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، نهج الحقّ وكشف الصدق: ص472، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج82، ص279.
[275] التوبة: آية24.
[276] المجادلة: آية22.
[277] اُنظر: طه: آية97. نص الآية الكريمة: (وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا).
[278] وقد كتب الإمام× كتاباً أجاب فيه على كتب أهل الكوفة، حيث قال: «... ومقالة جلّكم إنّه ليس علينا إمام، فأقبل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقّ...، فلعمري ما الإمام إلّا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحقّ، والحابس نفسه على ذات الله. والسلام». (الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص353).
[279] اُنظر: ابن سينا، حسين بن عبد الله، رسائل ابن سينا: ص250.
[280] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين: ص17، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص353.
[281] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص38، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص353.
[282] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص39: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص334.
[283] سبأ: آية46.
[284] النساء: آية135.
[285] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص39.
[286] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص20، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج28، ص353.
[287] ابن شهر أشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب×: ج3، ص217، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج32، ص331.
[288] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج1، ص102ـ 103.
[289] المائدة: آية50.
[290] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: حكمة262.
[291] الكهف: آية51.
[292] اُنظر: الأمالي، الصدوق، ص154-155، بحار الأنوار، ج44، ص315. «وسار الحسين× حتّى نزل في قصر بني مقاتل، فإذا هو بفسطاط مضروب، ورمح منصوب، وسيف معلّق، وفرس واقف على مذوده، فقال الحسين×: لِمَن هذا الْفُسْطاط؟ فقيل: لرجل يقال له: عبيد الله بن الحرّ الجعفي. قال: فأرسل الحسين× برجل من أصحابه يقال له: الحجّاج بن مسروق الجعفي. فأقبل حتّى دخل عليه في فسطاطه، فسلّم عليه، فردّ عليه السلام، ثمّ قال: ما وراءك؟ فقال الحجّاج: والله، ورائي يا بن الحرّ، والله، قد أهدى الله إليك كرامة إن قبلتها، قال: وما ذاك؟ فقال: هذا الحسين بن علي÷ يدعوك إلى نصرته، فإن قاتلت بين يديه أُجرت، وإن متّ فإنّك استشهدت، فقال له عبيد الله: والله، ما خرجت من الكوفة إلّا مخافة أن يدخلها الحسين بن علي÷ وأنا فيها فلا أنصره؛ لأنّه ليس في الكوفة شيعة ولا أنصار إلّا وقد مالوا إلى الدنيا، إلّا مَن عصم الله منهم، فارجع إليه وخبّره بذاك. فأقبل الحجّاج إلى الحسين×، فخبّره بذلك، فقام الحسين×، ثمّ صار إليه في جماعة من إخوانه، فلمّا دخل وسلّم، وثب عبيد الله بن الحرّ من صدر المجلس، وجلس عبيد الله بن الحرّ من صدر المجلس، وجلس الحسين، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أَمّا بَعد، يا بن الحُرّ، فإِنَّ مِصرَكُم هذِه كَتَبُوا إِلَيَّ وَخَبَّرُوني أَنَّهُم مُجْتَمِعون على نُصرَتي، وأَن يَقُومُوا دُوني وَيُقاتِلُوا عَدُوّي، وَأَنَّهُمْ سَأَلُوني الْقُدُومَ عَلَيْهِمْ، فَقَدِمْتُ، وَلَسْتُ أَدْري الْقَوْمَ عَلى ما زَعَمُوا؛ لأَِنَّهُمْ قَدْ أَعانُوا عَلى قَتْلِ ابْنِ عَمّي مُسْلِمِ بْنِ عَقيل& وَشيعَتِهِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ابْنِ مَرْجانَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِياد يُبايِعُني لِيَزيدَ بْنِ مُعاوِيَةَ، وَأَنْتَ يا بن الحُرّ، فَاعْلَمْ أَنَّ الله مُؤاخِذُكَ بِما كَسَبْتَ وَأَسْلَفْتَ مِنَ الذُّنُوبِ فِي الأَْيّامِ الْخالِيَةِ، وَأَنا أَدْعُوكَ في وَقْتي هذا إِلى تَوْبَة تَغْسِلُ بِها ما عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ، وَأَدْعُوكَ إِلى نُصْرَتِنا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنْ أُعْطِيْنا حَقَّنا حَمِدْنَا الله عَلى ذَلِكَ وَقَبِلْناهُ، وَإِنْ مُنِعْنا حَقَّنا وَرُكِبْنا بِالظُّلْمِ كُنْتَ مِنْ أَعْواني عَلى طَلَبِ الْحَقِّ. فقال عبيد الله بن الحرّ: والله، يا بن بنت رسول الله، لو كان لك بالكوفة أعوان يقاتلون معك لكنت أنا أشدّهم على عدوّك، ولكنّي رأيت شيعتك بالكوفة وقد لزموا منازلهم خوفاً من بني أميّة ومن سيوفهم، فأنشدك بالله أن تطلب منّي هذه المنزلة، وأنا أواسيك بكلّ ما أقدر عليه، وهذه فرسي ملجمة، والله ما طلبت عليها شيئاً إلّا أذقته حياض الموت، ولا طُلبت وأنا عليها فلُحقت، وخذ سيفي هذا، فوالله ما ضربت به إلّا قطعت. فقال له الحسين×: يَا بنَ الحُرّ، ما جِئْناكَ لِفَرَسِكَ وَسَيْفِكَ، إِنَّما أَتَيْناكَ لِنَسْأَلَكَ النُّصْرَةَ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ بَخِلْتَ عَلَيْنا بِنَفْسِكَ فَلا حاجَةَ لَنا في شَىْء مِنْ مالِكَ، وَلَمْ أَكُنْ بِالَّذي أَتَّخِذُ الْمُضِلّينَ عَضُداً، لأَِنّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ’ وَهُوَ يَقُولُ: من سمع داعية أهل بيتي، ولم ينصرهم على حقّهم ألا أكبّه الله على وجهه في النار. ثمّ سار الحسين× من عنده ورجع إلى رحله».
[293] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص91، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص392ـ393.
[294] آل عمران: آية154.
[295] الضحى: آية11.
[296] الأنفال: آية42.
[297] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص66، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص85.
[298] ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن محمد، شرح نهج البلاغة: ج14، ص42، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج33، ص80ـ81.
[299] ولمّا وصل الأمر إلى الصفويين والقاجاريين اتبعوا نفس هذه الطريقة، وقد حاول البهلوي خداع الناس ومحاربة الإسلام العلويّ، فكان يسمّي الشوارع بتسميات فيها دلالة على العدل البهلوي، وكان يبني المساجد، ويطبع القرآن، وكان يقول للناس كما يقول فرعون: (إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ) (غافر: آية26)، وفعلاً قال البهلوي في حرم الإمام الرضا× في عام 1357: إنّي أخشى على ذهاب دين الناس بسبب العلماء ورجال الدين.
[300] إبراهيم: آية1.
[301] إبراهيم: آية5.
[302] الأعراف: آية129.
[303] محمد: آية38.
[304] التوبة: آية33.
[305] النساء: آية78.
[306] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب×: ج4، ص89، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329.
[307] البقرة: آية61.
[308] الأنبياء: آية155.
[309] البقرة: آية251.
[310] الحجّ: آية40.
[311] قالوا: إنّه لا يوجد في دين المسيحيّة جهاد دفاعي، ولكنّ هذا الأمر من أكاذيب الكنيسة، ولا ينبغي أبداً استفتاء الكنيسة لمعرفة ما جاء به عيسى في الإنجيل؛ وذلك لأنّ الكنيسة قد جعلت الإنجيل أسيراً ومقيَّداً بفتاواها التي تتّفق مع أهوائها، ولا تتّفق مع ما جاء في الإنجيل.
والمثقّفون المطّلعون على مذاهب الغرب، يعلمون أنّ الغرب يفْصل بين الدين والسياسة، وفكرة فصل الدين عن السياسية قد تعلّموها من الكنيسة، ولا بدّ من الرجوع إلى القرآن الكريم للاطّلاع على كلام المسيح والإنجيل غير المحرَّف، وعلى حدّ تعبير علماء الدين ومن جملتهم كاشف الغطاء&: لولا القرآن الكريم لما بقي للمسيحيّة واليهوديّة أثر في العصر الحاضر، فوجود المسيحيّة واليهوديّة، إنّما هو ببركة القرآن الكريم (كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء: ج4، ص323)؛ وذلك لأنّه لو لم يبيّن القرآن الكريم تلك الأمور، وعُرض على الناس التوراة والإنجيل المحرَّف، فنظراً إلى التقدّم الذي حصل في العلم، لا يؤمن بدين المسيحيّة واليهوديّة عاقل؛ وذلك لأنّ الدين الذي ينسب إلى الأنبياء شرب الخمر والزنا بالمحارم ـ العياذ بالله ـ (اُنظر: الكتاب المقدّس، سفر پیدایش: باب19، 25 ـ 26) والكتاب الذي يذكر مصارعة الله لبعض الأنبياء^ (اُنظر: الكتاب المقدّس، سفر پيدايش: باب32، ص50، هو دين لا يؤمن به الإنسان العاقل اللبيب ولا يقدّسه، فالدين الذي يتهم مريم العذراء‘ (اُنظر: الكتاب المقدّس، العهد الجديد، إنجيل متّى: باب1، ص1ـ2) هو دين غير مقبول، ولا يستمرّ. ولمّا نزل القرآن الكريم، ووصف مريم بالعذراء والموحى اليها، وأثنى على عيسى ووصفه بالقدسيّة، وطهّر الأنبياء، ونزّه مريم العذراء من الرجس، وقدّس أنبياء بني إسرائيل، فقد كرّم المسيحيّة واليهوديّة، وشرَّف التوراة والإنجيل، وأعطاهما قيمة، وهذا سبب بقاء اليهوديّة والمسيحيّة، فإذا أردنا أن نتعرّف على كلام عيسى المسيح أو موسى الكليم÷، وإذا أردنا التعرّف على التوراة والإنجيل، فلا بدّ من الرجوع إلى القرآن الكريم.
[312] الصف: آية14.
[313] التوبة: آية111.
[314] البقرة: آية111.
[315] الإنسان من دون الوحي كالحيوان المفترس، إنّ عبادة الأصنام والوثنيّة هي داء لم يبتل به المجتمع قبل عشرين قرناً أو أربعة عشر قرناً فحسب، بل إنّ كثيراً من الناس في العصر الحاضر قد ابتُلوا بعبادة الأصنام الحديثة، وبالرغم من أنّ الإنسان اليوم قد تطوّر في الصناعة، واستطاع الغوص في أعماق البحر، والانطلاق إلى عنان السماء، وتمكّن من فلق الذرّة، فهذا التقدّم لا يعني الاطّلاع على ما وراء الطبيعة؛ لأنّ الهجوم على طائرة مدنيّة تحمل 290 مسافراً، وقتلهم بأجمعهم بين السماء والأرض، هو عين الجاهليّة، وهذا ما تحكم به فطرة الإنسان السليمة، وتحكم بضرورة إدانته والمنع عن حدوثه، ولكنّ هذه الفاجعة المؤلمة حدثت وكأنّما لم يحصل شيء، فلم يدن ذلك أحد منهم، ولم يعترض أحد عليه، وكأنّه لم يُرتكب عمل قبيح، بل قدّموا لمن هجم على هذه الطائرة وسام الشجاعة. (اُنظر: غضنفري، كامران، أمريكا وبراندازي جمهوري إسلامي إيران: ص324). إذن فلولا الوحي لأصبح الإنسان حيواناً مفترساً، وإن ظهر الاختراع والابتكار والتقدّم في حياته العلميّة والصناعيّة، فهذا التقدّم لا يخرجه عن دائرته المحدّدة له، فالعالم بالرياضيات ـ مهما تقدّم ـ لا يخرج عن إطار الجمع والطرح والضرب والتقسيم، ويبقى فكره محدوداً في دائرة المقدار المتصل أو المنفصل، ولكنّ العالم الآخر لا مقدار فيه، ويمكن للإنسان في هذا الميدان أن يستغني عن الجمع والطرح والضرب، ولذا فقد اجتاز الأنبياء في مسيرتهم كثيراً من الأعراض والجواهر، وهاجروا عنها حتّى بلغوا في مسيرتهم هذه إلى نشأة العقل، وأحاطوا بما وراء الطبيعة، واطلعوا على الغيب، وإنّ متاعهم هو الهداية والإرشاد إلى عالم الغيب، ولذا يقول الله تعالى: (وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) (البقرة: آية151) وكلّ هذه الأهداف والغايات مرهونة بالدفاع المقدّس.
[316] الأنعام: آية75.
[317] الحديد: آية25.
[318] البقرة: آية204ـ206.
[319] البقرة: آية207.
[320] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص89، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329. كما ورد في المناقب: «أريد آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، أسير بسيرة جدّي وسيرة أبي علي بن أبي طالب» وفي البحار باختلاف في بعض الألفاظ: «أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب×».
[321]الفتح: آية29. (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا).
[322] ابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي، تحف العقول: ص245.
[323] الحديد: آية15.
[324] حافظ الشيرازي، محمد، ديوان غزليّات حافظ: الغزل225، ص305. وتمام البيت:
(از ره مرو به عشوه دنيا كه عجوز مكاره مي نشيند ومحتاله مي رود)
يصف الشاعر فيه تغيّر الدنيا وتقلّبها، فهي تقبل على الإنسان بالحيلة، ثمّ تغدر به وتمكر به وتمضي، وينصح العاقل أن لا يسلك الطريق إليها ويغتر بها.
[325] بيشوائي، مهدي، تاريخ قيام ومقتل جامع سيّد الشهداء×: ج1، ص530.
[326] كما هو حال عصرنا الحاضر، حيث إنّ الحكومة الأمريكيّة تحاول إدارة فتاوى الكنيسة، والإسرائيليون الأثرياء لديهم مراكز الفتوى الصهيونيّة، وكذا رجال السياسة في الحجاز، فإنّهم يديرون فتاوى الشيوخ الوهابيين، ويعطونها الشرعيّة، وبقيّة الحكومات تتبع نفس هذه الطريقة.
[327] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: كتاب53، فقرة71.
[328] نفس المصدر، كتاب 108، فقرة 17.
[329] نفس المصدر: 131.
[330] ابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي، تحف العقول: ص239.
[331] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص203، الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ص742.
[332] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: كتاب67.
[333] الراوندي، سعيد بن عبد الله، فقه القرآن: ج1، ص327، النوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل: ج9، ص358.
[334] سعدي، مفلح بن عبد الله، كلّيات سعدي: ص159. ومضمونه: لست أنت الحاجّ، بل الحاجّ هو الجمل؛ لأنّه مسكين يأكل الشوك ويحمل الأثقال وينقلها.
[335] ولذا فإنّ الصلاة والحجّ كانت قائمة في عصر طاغوت إيران، وأمّا العصر الحالي فلم يقتصر على الصلاة والحجّ، بل ارتفعت فيه أصوات المسلمين وهتافاتهم بالبراءة من المشركين في مكّة المكرّمة، التي يجتمع فيها المسلمون من شتّى البلدان والدول، ويصل ذلك الصوت والهتاف إلى شرق العالم وغربه، وليس هذا إلّا لتحرير الدين من الأسر.
[336] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: حكمة235.
[337] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص788، الكفعمي، إبراهيم بن علي، المصباح في الأدعية: ص489.
[338] قد يضحك الإنسان بسبب لمس بعض المواضع من بدنه، وقد يضحك أحياناً عند سماعه بعض المواقف الغريبة، وقد يبتسم لسماعه طريفة أدبيّة، فأسباب الضحك مختلفة، وكذا البكاء، فقد يبكي الإنسان بسبب تأثّر الأعصاب بالنغمة الحزينة للعزاء ولا ثواب فيه، وقد يكون سبب البكاء عاطفيّاً، فعند ما يرى الإنسان مظلوماً، يتألّم قلبه، فيبكي عليه، وقد يكون سبب البكاء عقليّاً، وذلك عندما يرى الإنسان الولاية والإمامة والدين وتعاليم السماء في خطر الضياع، وهذا ما حصل لسيّد الشهداء× وزينب الكبرى‘، وهذا البكاء يختلف عن أنواع البكاء الأخرى، فهذا البكاء بكاء عقلاني، وفيه فضيلة، ويرفع من المعرفة بحقيقة الإمامة، فتنحلّ به كثير من المشاكل.
[339] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص61، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص367.
[340] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب×: ج4، ص89، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص383ـ384. جاء نصّه: «أتى الحسين عبد الله بن العباس، فقال: يا بن عم، إنّي أتصبّر ولا أصبر، إنّي أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال، إنّ أهل العراق قوم غدر، فلا تقربنّهم، أقم بهذا البلد، فإنّك سيّد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا، فاكتب إليهم، فلينفوا عدوّهم، ثمّ أقدم عليهم، فإن أبيت إلّا أن تخرج، فسر إلى اليمن، فإنّ بها حصوناً وشعباً، وهى أرض عريضة طويلة، ولأبيك بها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتبثّ دعاتك، فإنّي أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية. فقال له الحسين: يا بن عم، إنّي و_الله_ لأعلم أنّك ناصح مشفق، ولكنّي قد أزمعت وأجمعت على المسير. فقال له ابن عباس: فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك _فوالله_ إنّي لخائف أن تُقتل كما قُتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه...».
[341] الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير: ج3، ص495. هذه العبارة قد وردت في مصادر أهل السنّة على أنّها حديث مروي عن النبي الأكرم’ (اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، (تفسير ابن كثير): ج3، ص10. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج2، ص355. ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير: ج3، ص248) وقد ورد في تفسير (في ظلال القرآن) أنّه قد نُقل على أنّه شعار الجاهليّة، وصحّحه النبي الأكرم’ (اُنظر: الشاذلي، سيد قطب، في ظلال القرآن: ج2، ص840). ولكنّ الحديث قد جاء في مصادر الإماميّة بهذا النحو: عن علي×، قال: قال رسول الله’: للمسلم على أخيه ثلاثون حقّاً...، وينصره ظالماً ومظلوماً، فأمّا نصرته ظالماً فيردّه عن ظلمه، وأمّا نصرته مظلوماً يعينه على أخذ حقّه. (الكراجكي، محمد بن علي، كنز الفوائد: ج1، ص306، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج71، ص236).
[342] اُنظر: البيروني، أبو ريحان، تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: ص93.
[343] لا يستطيع أحذق الأطبّاء أن يكتب وصفة دواء واحدة لجميع المرضى في المناطق الحارّة والباردة، ويعطي نوعاً واحداً من الدواء، وبمقدار واحد لجميع المرضى الذين يسكنون القطب الشمالي والقطب الجنوبي والمناطق الاستوائية، فكذلك لا يستطيع من ينادي بالعدالة في الغرب كتابة وصفة من العدالة قائمة على أساس طبيعة الإنسان وآدابه ورسومه المحدودة في بقعة جغرافيّة، ويقدّمها إلى مليارات الناس في العالم؛ لأنّ طبيعة الإنسان وآدابه ورسومه تتغيّير دائماً.
والظلم والجور الذي يرتكبه المخالفون لمنهج الأنبياء^ في مختلف بقاع العالم باسم الليبراليّة والديمقراطيّة، وتحت غطاء العدالة والحرّية، شاهد صدق على عجزهم، فالعدالة والحرّية وحقوق الإنسان غير المبتنية على مبدأ الفطرة الأصيل والمشترك بين جميع الإنسانيّة، مجرّد ألفاظ فارغة، يستطيع كلّ إنسان أن يفسّرها طبقاً لما يتناسب مع ميوله ورغباته. وما أعظم الجرائم التي ارتكبها مَن يدّعي اتّباع الأديان السماويّة لتحقيق الرغبات والأهواء والمنافع باسم الدين، والأُمويّون والعباسيّون نموذج واضح لذلك، وكان عبيد الله بن زياد _عامل يزيد على الكوفة_ يُطبّق آيات النفاق على الإمام الحسين× وأصحابه، ويطبّق آيات الإيمان على نفسه وأتباعه؛ ليُبيح بذلك قتل الإمام الحسين× وأصحابه (اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص385 ـ 386).
[344] السنائي الغزنوي، أبو المجد، ديوان الحكيم السنائي: ص308. ومضمونه:
إنّ ورقة التوت التي لا قيمة لها، يمكن أن تصبح حريراً غالي الثمن، فهذا الحرير هو نفسه ورقة التوت التي كانت لا قيمة لها، ولكن تمّ العمل عليها بواسطة دودة القزّ، حتّى أصبحت ذات قيمة، فكذلك الإنسان إذا بذل الجهود، وغذّى نفسه وعقله بالعلوم الدينيّة، وعمل بذلك، يصبح كالملائكة.
[345] آل عمران: آية14.
[346] الشورى: آية23.
[347] البقرة: آية10.
[348] الأحزاب: آية32.
[349] المائدة: آية52.
[350] الملك: آية3ـ4.
[351] طه: آية50.
[352] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: حكمة476.
[353] نفس المصدر: حكمة241.
[354] نفس المصدر: حكمة341.
[355] نفس المصدر: حكمة437.
[356] التميمي الآمدي، عبد الواحد بن محمد، غرر الحكم: ص212.
[357] النحل: آية90.
[358] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص127، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج37، ص74.
[359] النساء: آية84.
[360] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص127، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج37، ص74.
[361] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329، ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21.
[362] الانفطار: آية7.
[363] الشمس: آية7.
[364] الشمس: آية8.
[365] البقرة: آية239.
[366] الإسراء: آية85.
[367] إبراهيم: آية24ـ 25.
[368] ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن علي، عوالي اللآلي: ج4، ص103. «بهذا [ إشارة إلى العدل] قامت السماوات والأرض». الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5، ص266، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج18، ص232.
[369] إبراهيم: آية26.
[370] قد جعل الإسلام في باب الإرث للولد سهماً أكثر من البنت، وفي مواضع أخرى جعل سهم المرأة والرجل على حدّ سواء كالأب والأم، وجعل سهم إرث المرأة أكثر من الرجل في بعض الحالات كالبنت الواحدة مع أبوي المتوفى. (اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج39، ص111ـ117).
[371] النساء: آية11.
[372] الذاريات: آية22.
[373] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص61.
[374] العنكبوت: آية64.
[375] المالكي، ورّام ابن أبي فراس، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج1، ص150، ابن أبي جمهور الأحسائي، محمد بن علي، عوالي الئالي: ج4، ص73، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج4، ص43.
[376] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص301، ابن عربي، محيي الدين، تفسير القرآن الكريم: ج2، ص329.
[377] البهائي، محمد بن حسين، كلّيات أشعار وآثار فارسي شيخ بهائي: ص10. يشير الشاعر: إلى أنّ الوطن لا يتحدد بالأسماء كالعراق والشام ومصر.
[378] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص301، ابن عربي، محيي الدين، تفسير القرآن الكريم: ج2، ص329.
[379] شيخ الإشراق السهروردي، يحيى، مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق: ج3، ص462.
[380] البقرة: آية156.
[381] الحجر: آية29.
[382] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: آية38.
[383] التوبة: آية38.
[384] البقرة: آية125.
[385] اُنظر: جلال الدين المولوي، محمد بن محمد، كتاب فيه ما فيه: ص125، مضمون البيت: يشير الشاعر: إلى أنّ الكعبة يكفيها عظمة وجمالاً انتسابها إلى الله في قوله عزّ وجلّ: (طَهِّرْ بَيْتِيَ) فلا تحتاج في زينتها إلى القماش الفاخر.
[386] الحجر: آية29.
[387] المالكي، ورّام ابن أبي فراس، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج1، ص183، الديلمي، الحسن بن علي، إرشاد القلوب: ج1، ص89.
[388] الحاقّة: آية30ـ31.
[389] سعادت برور، علي، جمال آفتاب: ج9، غزل482، ص21. يرى الشاعر حافظ الشيرازي أنّ هذا العالم المادّي ليس إلّا مكان غربة، وينبغي قطع هذا الطريق كعابر سبيل للوصول إلى موطنه الأصلي والحقيقي.
[390] الحجرات: آية10.
[391] آل عمران: آية64.
[392] الممتحنة: آية8.
[393] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الكتاب53.
[394] نفس المصدر: كتاب3.
[395] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص120، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص51.
[396] الفتح: آية29.
[397] آل عمران: آية134.
[398] النحل: آية125.
[399] الحديد: آية25.
[400] نظامي كنجوي، إلياس بن يوسف، كلّيات الحكيم نظامي كنجوي: ج1، ص594. ومضمون البيتين: محيط خلّاب كهطول المزن، ويتجاذب فيه الجمال والجلال، فبذلك الجمال تكون زينة العالم، وبالجلال يكون الحكم والعدل.
[401] المائدة: آية8.
[402] النحل: آية90.
[403] الحديد: آية25.
[404] النساء: آية135.
[405] المائدة: آية8.
[406] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص455.
[407] الإمام الحسين× وارث الأنبياء^ من النبي آدم× حتّى الخاتم’، ووارث نبي الله يحيى، وكان الإمام الحسين× يذكر يحيى مراراً، ويعدّ المصيبة التي جرت عليه من هوان الدنيا عند الله تعالى، بحيث يُهدى رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، حيث قال: «إنّ من هوان الدنيا على الله، أنّ رأس يحيى بن زكريا أُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل» (ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص31). إنَّ السبب في ذكر الإمام الحسين× لما جرى على يحيى×، اشتراكهما في مقارعة الظالم، وظروف الإمام الحسين× مشابهة لظروف يحيى×، حيث كانا معا ينتظران الشهادة، ولذا كان يُذكّر الناس بانّ رأسه سيُهدى إلى البغي يزيد، كما أُهدي رأس يحيى إلى بغي من بغايا إسرائيل، ويذكر الله} في القرآن الكريم يحيى ويوصفه بكلمات فيها دلالة على عظمة منزلة يحيى، حيث يقول: (ﭑﭒﭓﭔ) (مريم: آية12). والتعبير بـ (خذ الكتاب بقوّة) من التعبيرات النادرة في القرآن الكريم، ولم يرد لغير يحيى من الأنبياء.
[408] المائدة آية8.
[409] المائدة: آية8.
[410] النحل: آية90.
[411] النساء: آية135.
[412] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص24.
[413] أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف: ص172، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص403.
[414] الجاثية: آية24.
[415] الأنعام: آية25.
[416] طه: آية64.
[417] الأعلى: آية14.
[418] الشمس: آية9.
[419] طه: آية64.
[420] الفرقان: آية44.
[421] البقرة: آية171.
[422] الأنعام: آية25.
[423] الشمس: آية9.
[424] طه: آية64.
[425] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: حكمة164.
[426] النحل: آية90.
[427] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الحكمة 465.
[428] الأحزاب: آية70.
[429] الأحزاب: آية21.
[430] البقرة: آية217.
[431] الكهف: آية20.
[432] التوبة: آية12.
[433] التوبة: آية7.
[434] الانشقاق: آية6.
[435] البقرة: آية197.
[436] المائدة: آية8.
[437] الأنفال: آية29.
[438] البقرة: آية282.
[439] البقرة: آية151.
[440] الطلاق: آية2.
[441] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة183، الفقرة11ـ12.
[442] الزمر: آية61.
[443] النساء: آية87.
[444] النساء: آية122.
[445] التوبة: آية111.
[446] الحجّ: آية37.
[447] السبزواري، ملّا هادي، شرح المنظومة: ج5، ص377.
[448] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص720، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: زيارة وارث.
[449] الكاشاني، علي بن أحمد، ديوان محتشم الكاشاني: ص323. ويشير الشاعر: إلى حدوث طوفان في كربلاء.
[450] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص132.
[451] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص720. القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: زيارة وارث.
[452] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص296ـ298.
[453] حينما كنّا نهتمّ بقضية الإمام الحسين× على مستوى الطقوس ورفع الأعلام فقط، أسرع الأجانب إلينا وتمكّنوا من أخذ تلك الطقوس منّا، ولكن لمّا نظرنا إلى النهضة الحسينيّة بنظرة أعمق من الطقوس، وأخذنا بنظر الاعتبار العنصرين المتقدّمين: الهداية والدفاع عن الشعب، حظينا بثورة السيّد الإمام الراحل+، ونصرة رجال الدين وقادته، وتآزرت الحوزة العلميّة والمدارس الآكاديميّة، وبعد هذا الانتصار أصبحت أبواب الجنان بوجه هذه البلاد مفتوحة، وأصبحت طرق السير إلى الجنّة معبّدة، والطرق المؤدّية إلى النار وعرة وصعبة، ومن موانع الطرق المؤدّية إلى النار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع وجود هذه الموانع يصعب دخول جهنّم؛ لمّا أصبحت وكأنّ أبوابها مغلقة.
[454] وكان بختيار [رئيس وزراء إيران في وقته] قد نظّم آنذاك مسيرة من مائة ألف لدعم القانون الأساسي، بحيث يحتاج إحباط هذه المسيرة إلى موقف أقوى، ولذا اعتمد الخطباء آنذاك على المثل العربي (سر سيلاً تصل) يعني سر كسرعة السيل تصل إلى المقصود، وأمّا السير كماء النهر والجدول فقد لا يوصل إلى المقصود؛ لأنّه يجفّ في هذه الصحراء الرمليّة، أو يواجه صخرة تمنعه عن مواصلة المسير، ولذا أصبح الناس كالسيل ببركة قيادة السيّد الإمام الراحل&، وقد نظّموا مسيرات مليونيّة في أيّام تاسوعاء وعاشوراء والأربعين و28 من صفر، وقد وصلوا إلى الهدف المنشود، أي: أنّهم أسقطوا نظام الحكم الملكي، وهيّئوا الأرضيّة المناسبة لتشكيل النظام الإسلامي، وهذا تجسيد لكربلاء الحقيقية.
[455] الأنبياء: آية107.
[456] سبأ: آية28.
[457] لمّا رجع مسلم من مكّة إلى المدينة، أخذ أمتعته التي يحتاجها في السفر، ثمّ ودّع قبر رسول الله’، واصطحب معه دليلين يدلّانه على الطريق من المدينة إلى الكوفة، وأضلّ الدليلان الطريق، ولمّا شارفوا على الموت، وجّهوا مسلم على الطريق الذي ينجيه وماتا، فكتب مسلم بن عقيل من ذلك الموضع كتاباً إلى الإمام الحسين×، شرح له فيه ما جرى عليهم، وطلب منه أن يبيّن له ماذا يصنع، وقد كتب الإمام الحسين× كتاباً يحذّره فيه من الخوف، ويشجّعه على مواصلة الطريق، فلمّا قرأ مسلم الكتاب واصل طريقه إلى الكوفة. (اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص39ـ 40، ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص32ـ33).
[458] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص41، ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص34ـ35.
[459] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص53ـ54، ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص50.
[460] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص154ـ 155، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص315. والعبارة في البحار: «... فأعرض عنه الحسين× بوجهه، ثمّ قال: لا حاجة لنا فيك ولا في فرسك، وما كنت متّخذ المضلّين عضداً، ولكن فر، فلا لنا ولا علينا، فإنّه مَن سمع واعيتنا أهل البيت، ثمّ لم يجبنا، كبّه الله على وجهه في نار جهنّم».
[461] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص50ـ51، ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص48ـ49. وفي الإرشاد: «فقال لشريح القاضي: ادخل على صاحبهم فانظر إليه، ثمّ اخرج وأعلمهم أنّه حيّ لم يقتل. فدخل فنظر شريح إليه، فقال هانئ _لمّا رأى شريحاً_: يا لله، يا للمسلمين، أهلكَت عشيرتي؟! أين أهل الدين؟! أين أهل البصر؟! والدماء تسيل على لحيته، إذ سمع الرجّة على باب القصر، فقال: إنّي لأظنّها أصوات مذحج وشيعتي من المسلمين، إنّه إن (دخل عليّ) عشرة نفر أنقذوني. فلمّا سمع كلامه شريح خرج إليهم، فقال لهم: إنّ الأمير لمّا بلغه مكانكم ومقالتكم في صاحبكم، أمرني بالدخول إليه، فأتيته فنظرت إليه، فأمرني أن ألقاكم وأن أعلمكم أنّه حي، وأنّ الذي بلغكم من قتله باطل، فقال عمرو بن الحجّاج وأصحابه: أمّا إذ لم يُقتل فالحمد لله، ثمّ انصرفوا».
[462] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص50ـ51، ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص48ـ49.
[463] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص55ـ56، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص371ـ372. وفي الإرشاد: «ثمّ خرج فصعد المنبر، وخرج أصحابه معه، فأمرهم فجلسوا قبيل العتمة، وأمر عمرو بن نافع فنادى: ألا برئت الذمّة من رجل مِن الشرط والعرفاء والمناكب أو المقاتلة صلّى العتمة إلّا في المسجد، فلم يكن إلّا ساعة حتّى امتلأ المسجد من الناس، ثمّ أمر مناديه فأقام الصلاة، وأقام الحرس خلفه، وأمرهم بحراسته من أن يدخل عليه أحد يغتاله، وصلّى بالناس، ثمّ صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال...».
[464] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص65. وجاء فيه: «وأمر كاتبه أن يكتب إلى يزيد بما كان من أمر مسلم وهانئ، فكتب الكاتب ـ وهو عمرو بن نافع ـ فأطال، وكان أوّل مَن أطال في الكتب، فلمّا نظر فيه عبيد الله تكرّهه، وقال: ما هذا التطويل؟ وما هذه الفصول؟ اكتب: أمّا بعد: فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقّه، وكفاه مؤنة عدوّه».
[465] ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص27، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص375.
[466] الأنبياء: آية51.
[467] الروم: آية4.
[468] الرحمن: آية29.
[469] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص67، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص386. وفي الإرشاد: «روي عن الفرزدق الشاعر، أنّه قال: حججت بأمّي في سنة ستّين، فبينا أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم، إذ لقيت الحسين بن علي÷ خارجاً من مكّة معه أسيافه وتراسه، فقلت: لمن هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي، فأتيته فسلّمت عليه، وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأمّلك فيما تحب، بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله، ما أعجلك عن الحجّ؟ فقال: لو لم أعجّل لأخذت، ثمّ قال لي: مَن أنت؟ قلت: امرؤ من العرب، فلا ـ والله ـ ما فتّشني عن أكثر من ذلك، ثمّ قال لي: أخبرني عن الناس خلفك، فقلت: الخبير سألت، قلوب الناس معك وأسيافهم عليك، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء، فقال: صدقت، لله الأمر، وكلّ يوم ربّنا هو في شأن... ».
[470] اُنظر: الإرشاد: ج2، ص67ـ68. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنور: ج44، ص365. وبطبيعة الحال أنّ والي مكّة قد أخبر عبيد الله بن زياد بكلّ ما يتعلّق بنيّة الإمام الحسين×، وقد وضع الحرس على جميع الطرق المؤدّية إلى الكوفة، بحيث إنّ الإمام الحسين× لا يمكنه أن يرجع إلى المدينة ولا إلى الكوفة، وكلّ مَن يخرج من الكوفة ويدخل إليها تحت مراقبة الحرس. اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص165.
[471] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص385. ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص39. وفي تاريخ الطبري: «لمّا خرج الحسين× من مكّة، اعترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص، عليهم يحيى بن سعيد، فقالوا له: انصرف، أين تذهب، فأبى عليهم ومضى، وتدافع الفريقان، فاضطربوا بالسياط، ثمّ إنّ الحسين وأصحابه امتنعوا امتناعاً قويّاً، ومضى الحسين× على وجهه، فنادوه: يا حسين، ألا تتّقي الله، تخرج من الجماعة وتفرّق بين هذه الأُمّة، فتأوّل الحسين× قول الله : (لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ)».
[472] يونس: آية41.
[473] وكتب أمير المدينة الوليد بن عتبة إلى ابن زياد: «أمّا بعد، فإنّ الحسين قد توجّه إلى العراق، وهو ابن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله، فاحذر يا بن زياد أن تأتي إليه بسوء، فتهيج على نفسك وقومك أمراً في هذه الدنيا لا يصدّه شيء، ولا تنساه الخاصّة والعامّة أبداً ما دامت الدنيا. قال: فلم يلتفت ابن زياد إلى كتاب الوليد» المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص368، ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص70.
[474] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص382. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص403. ثمّ قال: «ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفئ، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر، وقد أتتني كتبكم، وقدمت علىّ رسلكم ببيعتكم، أنّكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسي مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم فيّ أسوة، وإن لم تفعلوا، ونقضتم عهدكم، وخلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّى مسلم، والمغرور مَن اغترّ بكم، فحظّكم أخطأتم، ونصيبكم ضيّعتم، ومَن نكث فإنّما ينكث على نفسه، وسيغنى الله عنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
[475] الأعراف: آية38.
[476] بعد وصول كتاب مسلم، وقبل وصول خبر شهادته للإمام×، قد كتب الإمام× كتاباً إلى أهل الكوفة، وأرسله بيد رسول كي يوصله لهم، فلمّا وقع الرسول بأيدي حرس ابن زياد، مزّق الكتاب، فسأله ابن زياد: لماذا مزّقت الكتاب؟ قال: إنّ الكتاب كان من قبل الإمام الحسين× إلى رجال من أهل الكوفة، ولا أريد أن تطّلع عليهم، فغضب ابن زياد، فقال: والله لا تفارقني حتّى تخبرني بأسماء هؤلاء القوم، أو تصعد المنبر وتلعن الحسين بن علي وأباه وأخاه، وإلّا قطّعتك إرباً إرباً، فقال قيس: أمّا القوم فلا أخبرك بأسمائهم، وأمّا لعنة الحسين وأبيه وأخيه فأفعل، فصعد المنبر، وحمد الله، وصلّى على النبي، وأكثر من الترحّم على علي وولده صلوات الله عليهم، ثمّ لعن عبيد الله بن زياد وأباه، ولعن عتاة بني أُميّة عن آخرهم، ثمّ قال: أنا رسول الحسين إليكم، وقد خلّفته بموضع كذا فأجيبوه...، فأمر به عبيد الله بن زياد أن يُرمى من فوق القصر، فرمي به فتقطّع. (ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص75ـ77، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص369ـ370).
[477] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص89، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص391. جدير بالذكر أنّ ما يدلّ على هذا الكلام قول عمر بن سعد: «يا خيل الله اركبي وبالجنّة أبشري».
[478] آل عمران: آية178ـ179.
[479] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص95، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص321. وفي الإرشاد: «قال الضحّاك بن عبد الله: ومرّ بنا خيل لابن سعد يحرسنا، وإنّ حسيناً ليقرأ: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ * مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ) فسمعها من تلك الخيل رجل يقال له: عبد الله بن سمير، وكان مضحاكاً، وكان شجاعاً بطلاً فارساً فاتكاً شريفاً، فقال: نحن وربّ الكعبة الطيّبون، ميّزنا منكم».
[480] اُنظر: ابن نما الحلّي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص65، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص439. «... ثمّ قال: سلوهم أن يكفّوا عنّا حتّى نصلّى، فقال لهم الحصين بن تميم: إنّها لا تقبل...».
[481] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص72ـ73، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص396. وفي الإرشاد: «فأتاه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشراً قد أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله ورحله ومتاعه فقُوّض وحمل إلى الحسين×، ثمّ قال لامرأته: أنت طالق، الحقي بأهلك، فإنّي لا أحبّ أن يصيبك بسببي إلّا خير، ثمّ قال لأصحابه: من أحبّ منكم أن يتبعني، وإلّا فهو آخر العهد».
[482] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص72ـ73، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص396.
[483] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص723، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج89، ص201.
[484] الأعراف: آية58.
[485] إبراهيم: آية24.
[486] إبراهيم: آية26.
[487] إنّ السيّد الإمام الراحل كان لديه فرصة كبيرة، وفسّر الإسلام بشكل كامل، وبيّن حدود الإسلام الخالص من غيره، وذكر نصوصاً مختصرة كدستور، يجب على المتحدّثين والكتّاب شرحها كي يتّضح أنّ الجمهورية كالإسلام، يمكن أن تنقسم إلى خالصة وغير خالصة، كما أنّ السيّد الإمام الخميني قبل أن يفسّر المعارف الإسلاميّة الأصيلة، قد نقّى الناس وطهّرهم من أوساخ التبعيّة إلى الشرق والغرب، وقد رفعهم إلى مستوى من الوعي جعلهم يتعلّقون بالقرآن والعترة، ويغفلون عن أقوال غيرهما. «اليمين والشمال مضلّة والطريق الوسطى هي الجادّة». (الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة16) إنّ الناس غير الخلّص لا يرضون بالدين الخالص، وبما أنّ الشرق والغرب غير خالصين، فلم يدخلوا الإسلام، ولذا قام السيّد الإمام _متأسّياً بالأنبياء_ بتنقية وتطهير الناس أوّلاً، ثمّ صبّ الماء في هذا الإناء الطاهر الطيّب.
[488] المائدة: آية68.
[489] اُنظر: الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج6، ص64ـ65.
[490] المزمل: آية5.
[491] الحشر: آية21.
[492] المفيد، محمد بن محمد، الاختصاص: ص6، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج34، ص274.
[493] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص241.
[494] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص241.
[495] لا يستغني أحد عن نهضة كربلاء؛ لأنّها حركة تربّي المجاهدين على الجهاد الأصغر، وترشد المجاهدين وعلماء الأخلاق إلى الجهاد الأوسط، وتربّي العرفاء المستغرقين في الله تعالى، وتدعوهم إلى (الصحو بعد المحو، والمحو قبل الصحو). إنّ القرآن الكريم يقول: إن أنفقتم درهماً واحداً فكأنّما زرعتم حبّة في الأرض، وتلك الحبّة تنبت سبع سنابل، وفي كلّ سنبلة مائة حبّة، أي: أنّ السنبلة الواحدة تتحوّل إلى سبعمائة حبّة، ثمّ يقول: (وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) (البقرة: آية261). أي: أنّ الله تعالى يضاعف السبعمائة حبّة إلى ألف وأربعمائة حبّة، أو يضاعف مطلقاً ومن دون حساب (وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة: آية261).
نعم، إنّ الله تعالى حينما يقول: (يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (الزمر: آية10) فلا يعني هذا الكلام أنّ الله تعالى يجازيهم من دون حساب، لأنّ كلّ شيء له قدر وحدود في نظام الوجود (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (القمر: آية49). فلا يوجد شيء في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة إلّا وهو خاضع للهندسة والمقادير، وإنّما المقصود أنّ عطاء الله للصابرين كثير جدّاً، إلى حدّ لا يمكن حسابه وعدّه، إذن فحينما يعطي الله تعالى على إنفاق المال أجراً بغير حساب، فإعطاؤه الأجر بغير حساب على التضحية بالنفس بطريق أولى، ويهب الذين يضحّون بأنفسهم في سبيل الله حياة أبديّة بغير حساب، وبعبارة أخرى أنّ الإنسان إذا ضحّى بحياة زائلة سيهبه الله حياة أبديّة تعدل أضعاف تلك الحياة الزائلة (نظامي كنجوي، إلياس بن يوسف، كلّيات نظامي كنجوي: ج1، ص601).
وإنّما وصف الله تعالى إبراهيم الخليل بأنّه أمّة؛ لأنّ تضحياته تعادل تضحيات أمّة كاملة (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا) (النحل: آية120) ولذا قال الإمام الراحل& بشأن الشهيد بهشتي+: «إنّ الشهيد بهشتي كان أمّة» (الخميني، روح الله، صحيفة السيّد الإمام&: ج15، ص18) إذن فبناء على هذا المعيار يمكن أن يقال: غنّ قيمة الشهيد تعادل قرية أو مدينة أو بلد كامل أو العالم بأسره، وهذا الاختلاف يرجع إلى درجة الشهيد ومنزلته.
[496] آل عمران: آية133.
[497] الحديد: آية21.
[498] مريم: آية74.
[499] الفرقان: آية74.
[500] الحجّ: آية41.
[501] العنكبوت: آية45.
[502] النمل: آية34.
[503] المعارج: آية19ـ22.
[504] الأنبياء: آية58.
[505] الأنبياء: آية68.
[506] الأنبياء: آية69.
[507] البقرة: آية124.
[508] النساء: آية54.
[509] الدَبَر ـ بالتحريك ـ القرحة في ظهر الدابّة. والوبر: شعر الجمال. والمراد: أنّهم رعاة. ونصّ الخطبة: «فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني إسرائيل^، فما أشدّ اعتدال الأحوال، وأقرب اشتباه الأمثال، تأمّلوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرّقهم ليالي كانت الأكاسرة والقياصرة أرباباً لهم، يحتازونهم عن ريف الآفاق، وبحر العراق وخضرة الدنيا إلى منابت الشيح، ومهافي الريح، ونكد المعاش، فتركوهم عالة مساكين إخوان دبر ووبر، أذلّ الأمم داراً، وأجدبهم قراراً»، (الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة192).
[510] اُنظر: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة192، الفقرة92ـ102. قال× في الخطبة: «فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولاً، فعقد بملّته طاعتهم، وجمع على دعوته ألفتهم. كيف نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها، وأسالت لهم جداول نعيمها، والتفّت الملّة بهم في عوائد بركتها. فأصبحوا في نعمتها غرقين، وعن خضرة عيشها فكهين. قد تربّعت الأمور بهم، في ظل سلطان قاهر، وآوتهم الحال إلى كنف عزّ غالب، وتعطّفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت، فهم حكّام على العالمين، وملوك في أطراف الأرضين، يملكون الأمور على مَن كان يملكها عليهم، ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم، لا تُغمز لهم قناة، ولا تُقرع لهم صفاة».
[511] الإسراء: آية8.
[512] الأنفال: آية19.
[513] ابن هلال الثقفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج1، ص28، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج34، ص51. وفي البحار: «يا معاشر أهل الكوفة، والله لتصبرنّ على قتال عدوّكم، أو ليسلطنّ الله عليكم قوماً أنتم أولى بالحقّ منهم، فليعذبنّكم وليعذبنّهم الله بأيديكم، أو بما شاء من عنده».
[514] اُنظر: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة116. قال: «أمَا والله لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُم غلَام ثَقيفٍ، الذيَّال الْمَيَّال، يَأْكُل خَضِرَتَكُم ويُذِيبُ شَحْمَتَكُم؛ إِيهٍ أَبَا وَذَحَةَ».
[515] النمل: آية34.
[516] ولذا صمدت الجمهورية الإسلاميّة، ولم تخضع ولم تعرف الاستسلام، لا في الثورة ولا في الحرب ولا في الحصار الاقتصادي، وقد اجتازت هذه المراحل الثلاث بكلّ جدارة؛ لأنّها تعتمد على المدرسة الحسينيّة، ولها قائد خبير، ذلك القائد الذي خاطب العدو: بالرغم من أنّكم تمتلكون القوّة الجويّة، لكن يجب في النهاية أن تستسلموا وتواجهوا الناس، وهؤلاء الناس لا يسمحون لكم بذلك أبداً. (اُنظر: الخميني، روح الله، صحيفة الإمام: ج16، ص521).
[517] آل عمران: آية140.
[518] وكما شاهدنا في عقود ما قبل الثورة الإسلاميّة في إيران، فإنّ هناك فريقاً قد رحلوا عن السلطة والمنعة والقوّة بسبب الثورة، وذهبوا إلى مزبلة التاريخ واليوم قد تكفّل شؤون البلاد جماعة أخرى بفضل الثورة الإسلاميّة، إذن فعلينا معرفة المجال الذي نعيش فيه، ولا نشتكي من تقلّبات الدهر.
[519] الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص343، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج70، ص103.
[520] النساء: آية122.
[521] البلد: آية4.
[522] الأعراف: آية99.
[523] القصص: آية83.
[524] النحل: آية97.
[525] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص83، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص408. وفي الإرشاد: «أمّا بعد، فجعجع بالحسين حين يبلغك كتابي، ويقدم عليك رسولي، ولا تنزله إلّا بالعراء في غير حصن، وعلى غير ماء، فقد أمرت رسولي أن يلزمك ولا يفارقك حتّى يأتيني بإنفاذك أمري، والسلام».
[526] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص84، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص408.
[527] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص98، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص191.
[528] جاء في بعض الكتب كالإرشاد: ج2، ص79، «وكان رأيكم الآن غير ما أتتني به كتبكم أنصرف عنكم»، وقوله: «لو ترك القطا لنام» الإرشاد: ج2، ص93. وورد في تاريخ الطبري: ج5، ص425، «إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض».
[529] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص64ـ65، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص364، وجاء نصّه: «فلمّا كان السحر ارتحل الحسين×، فبلغ ذلك ابن الحنفيّة، فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها، فقال له: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى، قال: فما حداك على الخروج عاجلاً، فقال: أتاني رسول الله ’ بعد ما فارقتك، فقال: يا حسين، اخرج فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً، فقال له ابن الحنفيّة: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك، وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟ قال: فقال له: قد قال لي: إنّ الله قد شاء أن يراهنّ سبايا. وسلّم عليه ومضى».
[530] السنائي القزنوي، مجدود بن آدم، ديوان حكيم سنايي غزنوي: ص335، رقم 154.
[531] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص90، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص419. وقد جاء فيه: «فلمّا كان الليل، قال: هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملاً، ثمّ ليأخذ كلّ رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثمّ تفرّقوا في سوادكم ومدائنكم...».
[532] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص64ـ65، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 44، ص364.
[533] القمّي، عباس، نفس المهموم: ص65.
[534] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، معاني الأخبار: ص288ـ289، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص297. وجاء نصّه: «عن أبي جعفر الثاني، عن آبائه^، قال: قال علي بن الحسين×: لمّا اشتدّ الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب، نظر إليه مَن كان معه، فإذا هو بخلافهم؛ لأنّهم كلّما اشتدّ الأمر تغيّرت ألوانهم، وارتعدت فرائصهم، ووجلت قلوبهم، وكان الحسين× وبعض مَن معه من خصائصه تشرق ألوانهم، وتهدأ جوارحهم، وتسكن نفوسهم...».
[535] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص120ـ 121، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص53.
[536] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص64ـ65، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: 44، ص364.
[537] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص11، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج1، ص116.
[538] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة224.
[539] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص76، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك، (تاريخ الطبري): ج5، ص398ـ399. والنصّ في الطبري: «قال الأسديّان: ثمّ انتظر حتّى إذا كان السحر، قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء، فاستقوا وأكثروا، ثمّ ارتحلوا وساروا حتّى انتهوا إلى زبالة».
[540] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص76، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك، (تاريخ الطبري): ج5، ص398ـ399. وجاء نصّه: « ثمّ إنّ رجلاً قال: الله أكبر، فقال الحسين: الله أكبر، ما كبّرت؟ قال: رأيت النخل، فقال له الأسديّان: إنّ هذا المكان ما رأينا به نخلة قط، قالا: فقال لنا الحسين: فما تريانه رأى؟ قلنا: نراه رأى هوادى الخيل، فقال: وأنا _والله_ أرى ذلك، فقال الحسين: أما لنا ملجأً نلجأ إليه، نجعله في ظهورنا، ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقلنا له: بلى، هذا ذو حسم إلى جنبك، تميل إليه عن يسارك، فإن سبقت القوم إليه فهو كما تريد، قال: فأخذ إليه ذات اليسار، قال: وملنا معه، فما كان بأسرع مِن أن طلعت علينا هوادى الخيل، فتبيّناها وعدلنا، فلمّا رأونا وقد عدلنا عن الطريق، عدلوا إلينا، كأنّ أسنّتهم اليعاسيب، وكأنّ راياتهم أجنحة الطير، قال: فاستبقنا إلى ذي حسم، فسبقناهم إليه، فنزل الحسين فأمر بأبنيته فضُربت، وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحرّ بن يزيد التميمي اليربوعي، حتّى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حرّ الظهيرة، والحسين وأصحابه معتمّون متقلدو أسيافهم، فقال الحسين لفتيانه: اسقوا القوم وأرووهم من الماء، ورشّفوا الخيل ترشيفاً، فقام فتيانه فرشّفوا الخيل ترشيفاً، فقام فتية وسقوا القوم من الماء حتّى أرووهم، وأقبلوا يملؤون القصاع والأتوار والطساس من الماء، ثمّ يدنونها من الفرس، فإذا عبّ فيه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه وسقوا آخر، حتّى سقوا الخيل كلّها».
[541] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص77ـ79، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك، (تاريخ الطبري): ج5، ص401ـ 402.
[542] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص87، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك، (تاريخ الطبري): ج5، ص412.
[543] البقرة: آية30.
[544] الحديد: آية25.
[545] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة1.
[546] الدخان: آية18. والآية مع ما قبلها كالتالي: (وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ (17) أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ).
[547] غافر: آية26.
[548] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج8، ص177.
[549] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص694، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج66، ص406.
[550] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص248، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج47، ص29.
[551] المصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم: ج11، ص65، (م ر ج).
[552] حافظ الشيرازي، محمد، ديوان غزليّات حافظ: ج11، ص17. ويشير الشاعر إلى أنّ من أحيى قلبه بالعشق فهو حي لا يموت .
[553] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص738ـ739.
[554] من الأخلاق الملائكيّة ليوسف الصدّيق، أنّه بالرغم من تحمّله المصاعب، لمّا أراد أن يبيّن الحقّ، ويذكّر أُخوته بنعمة الله عليه، ويشرح ما جرى عليه من المصاعب، قال: (...وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ...) (يوسف: آية100) ولكنّه لم يذكر قصّة الجبّ كي لا يُحرج أخوانه، والحال أنّ أكثر المشاكل والمصاعب إنّما تحمّلها بسبب غيابة الجبّ؛ لأنّهم لو لم يلقوه في غيابة الجبّ ويبيعوه بدراهم معدودات، لما أصبح خادماً، ولا اتُّهم بتلك التهمة، ولما دخل السجن في مصر وبقي فيه سنين طويلة، ولو كان في ذلك المجلس زليخا أو أمثالها لما ذكر السجن أيضاً.
[555] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص720.
[556] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك، (تاريخ الطبري): ج5، ص403.
[557] ابن شعبة الحرّاني، حسن بن علي، تحف العقول: ص239، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج97، ص81.
[558] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص66، 79، بحار الأنوار: ج44، ص381، ج45، ص85. وهذا الكلام مقتبس من كلمات الإمام الحسين× المختلفة، حيث قال: «فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برماً» وقوله في خطاب آخر: «أمّا بعد، فإنّه مَن لحق بي منكم استشهد معي، ومن تخلّف لم يبلغ الفتح».
[559] الطوسي، محمد بن الحسن، مصباح المتهجّد: ج2، ص720.
[560] نفس المصدر: ج2 ص774.
[561] المفيد، محمد بن محمد، كتاب المزار: ص206.
[562] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الكتاب53، الفقرة110.
[563] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص39.
[564] الحديد: آية23.
[565] ابن طاوس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص334.
[566] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج5، ص537، الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج20، ص236.
[567] اُنظر: الخصيبي، حسين بن حمدان، الهداية الكبرى: ص225ـ226. ونص الرواية: «عن أبي خالد الكابلي، قال: خدمت محمد بن الحنفيّة سبع سنين، ثمّ قلت له: جعلت فداك، إنّ لي إليك حاجة، قد عرفت خدمتي لك، قال: فاسأل حاجتك، قلت: تريني الدرع والمغفر، قال: ليس هما عندي، ولكن عند ذلك الفتى، وأشار بيده إلى مولانا زين العابدين علي بن الحسين÷، فنظرت إليه حتّى انصرف، وأتبعته حتّى عرفت منزله، فلمّا كان من الغد، وتعالى النهار، أقبلت فإذا بابه مفتوح، فأنكرت ذلك؛ لأنّي كنت أرى أبواب الأئمّة^ تطبق أبداً، فقرعت الباب، فصاح: يا كنكر أدخل، فدخلت عليه، فقلت: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً عبده ورسوله، وأنّك حجّة الله على جميع خلقه، وهذا _والله_ لقبي لقبتني به أمّي، وما عرفه خلق، قال: اجلس فأنا حجّة الله وخزانة وحي الله، فينا الرسالة والنبوّة والإمامة ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله وبنا يختم، قال أبو خالد: فأطلت الجلوس، ووقع على قلبي الفكر في فتح الباب، وكانت لحيته بطيب وعليه ثوبان موردان، فقال: يا كنكر، تعجب من فتح الباب، ومن الخصلة والطبع الذي في الثوبين؟ قلت: نعم، قال: يا أبا محمد، أمّا الباب فخرجت خادمة من الدار لا علم لها، فتركت الباب مفتوحاً، ولا يجوز لبنات رسول الله| أن يبرزن فيصفقنه، وأمّا الخصلة فليس أنا فعلتها، لكن النساء أخذن طيباً فخصلنني به، وأمّا الطبع في الثوبين فأنا قريب العهد بعرش ابن عمّي، ولي منذ استخرجتها أربعة أيّام...».
[568] اُنظر: البحراني، عبد الله، عوالم العلوم: ج11، ص955. ونص الرواية كالتالي: «كنت في جوار أمير المؤمنين في المدينة مدّة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فلا _والله_ ما رأيت لها شخصاً، ولا سمعت لها صوتاً، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدّها رسول الله تخرج ليلاً، والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين× أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين× فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن× مرّة عن ذلك، فقال×: أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أختك زينب».
[569] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص115 «فدخلت زينب أخت الحسين في جملتهم متنكّرة، وعليها أرذل ثيابها، فمضت حتّى جلست ناحية من القصر، وحفّت بها إماؤها».
[570] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف، ص83. «ثمّ وضع رأس الحسين× بين يديه، وأجلس النساء خلفه؛ لئلّا ينظرن إليه، فرآه علي بن الحسين÷ فلم يأكل بعد ذلك أبداً، وأمّا زينب فإنّها لمّا رأته أهوت إلى جيبها فشقّته، ثمّ نادت بصوت حزين يفزع القلوب: يا حسيناه...».
[571] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص108.
[572] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج6، ص113، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص354.
[573] اُنظر: الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج3، ص394، مادة (ع ب ر).
[574] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص137.
[575] الحديد: آية3.
[576] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص17.
[577] اُنظر: الطبرسي، الفضل بن حسين، إعلام الورى: ص218ـ219.
[578] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص330، الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص231ـ232.
[579] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص129ـ130. جاء نصّه: «وروى الأوزاعي، عن عبد الله بن شداد، عن أم الفضل بنت الحارث، أنّها دخلت على رسول الله’، فقالت: يا رسول الله، رأيت الليلة حلماً منكراً، قال: وما هو؟ قالت: إنّه شديد، قال: ما هو؟ قالت: رأيت كأنّ قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري، فقال رسول الله’: خيراً رأيت، تلد فاطمة غلاماً فيكون في حجرك، فولدت فاطمة الحسين×، فقالت: وكان في حجري كما قال رسول الله|، فدخلت به يوماً على النبي’، فوضعته في حجره، ثمّ حانت منّي التفاتة، فإذا عينا رسول الله عليه وآله السلام تهراقان بالدموع، فقلت: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، ما لك؟ قال: أتاني جبرئيل×، فأخبرني أنّ أمّتي ستقتل ابني هذا، وأتاني بتربة من تربته حمراء. وفي رواية أخرى: وروى سماك، عن ابن مخارق، عن أم سلمة،I قالت: بينا رسول الله’ ذات يوم جالس والحسين× جالس في حجره، إذ هملت عيناه بالدموع، فقلت له: يا رسول الله، ما لي أراك تبكي، جعلت فداك؟ فقال: جاءني جبرئيل×، فعزّاني بابني الحسين، وأخبرني أن طائفة من أمّتي تقتله، لا أنالهم الله شفاعتي».
[580] اُنظر: الخوارزمي، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص213ـ214.
[581] اُنظر: الخصيبي، حسين بن حمدان، الهداية الكبرى: ص148، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص266. ونص الرواية كالتالي: «عن عبد الله ابن قيس، قال: كنت مع مَن غزى مع أمير المؤمنين× في صفّين، وقد أخذ أبو أيّوب الأعور السلمي الماء، وحرزه عن الناس، فشكى المسلمون العطش، فأرسل فوارس على كشفه، فانحرفوا خائبين، فضاق صدره، فقال له ولده الحسين× أمضي إليه يا أبتاه؟ فقال: امض يا ولدي، فمضى مع فوارس، فهزم أبا أيّوب عن الماء، وبنى خيمته وحطّ فوارسه، وأتى إلى أبيه وأخبره. فبكى علي×، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين، وهذا أوّل فتح ببركة الحسين×؟ فقال: ذكرت أنه سيقتل عطشاناً بطفّ كربلاء، حتّى ينفر فرسه ويحمحم ويقول: الظليمة الظليمة لأمّة قتلت ابن بنت نبيّها».
[582] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص145. جاء نصّه: «إنّ الحسن× لمّا دنت وفاته، ونفدت أيّامه، وجرى السمّ في بدنه، تغيّر لونه واخضرّ، فقال له الحسين×: ما لي أرى لونك مائلاً إلى الخضرة؟ فبكى الحسن×، وقال: يا أخي، لقد صحّ حديث جدّي فيّ وفيك، ثمّ اعتنقه طويلاً وبكيا كثيراً...».
[583] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص209، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص149.
[584] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج1، ص299. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص285ـ286. جاء نصّه: «عن علي، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، قال: دخلت على الرضا× في أوّل يوم من المحرّم، فقال لي: يا بن شبيب، أصائم أنت؟ فقلت: لا، فقال: إنّ هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريّا ربّه،} فقال: ربّ هب لي من لدنك ذرّية طيّبة، إنّك سميع الدعاء، فاستجاب الله له، وأمر الملائكة فنادت زكريّا وهو قائم يصلي في المحراب، أنّ الله يبشّرك بيحيى، فمَن صام هذا اليوم، ثمّ دعا الله} استجاب الله له كما استجاب لزكريّا×. ثمّ قال: يا بن شبيب، إنّ المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة فيما مضى يحرّمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأمّة حرمة شهرها، ولا حرمة نبيّها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذرّيته، وسبوا نساءه، وانتهبوا ثقلة، فلا غفر الله لهم ذلك أبداً. يا بن شبيب، إن كنت باكياً لشيء، فابك للحسين بن علي بن أبي طالب÷، فإنّه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً، مالهم في الأرض شبيهون...».
[585] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار الكبير: ص501، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص238.
[586] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار الكبير: ص504ـ505، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص240ـ241ـ322.
[587] الكفعمي، إبراهيم، المصباح في الأدعية: ص741.
[588] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص100ـ104.
[589] الصدوق، محمد بن علي، من لا يحضره الفقيه: ج2، ص584.
[590] اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج14، ص329.
[591] ابن فهد الحلي، أحمد، عدّة الداعي: ص57.
[592] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص274. جاء نصّه: «حدثني علي بن الحسين وجماعة، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن أبي هاشم الجعفري، قال: دخلت أنا ومحمد بن حمزة عليه نعوده، وهو عليل، فقال لنا: وجّهوا قوماً إلى الحائر من مالي، فلمّا خرجنا من عنده، قال لي محمد بن حمزة: المشير يوجّهنا إلى الحائر، وهو بمنزلة مَن في الحائر، قال: فعدت إليه فأخبرته، فقال لي: ليس هو هكذا، إنّ لله مواضع يحب أن يُعبد فيها، وحائر الحسين× من تلك المواضع. وفي رواية أخرى: فقال لي: ألا قلت له: إنّ رسول الله’ كان يطوف بالبيت ويقبّل الحجر، وحرمة النبي’ والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله أن يقف بعرفة، إنّما هي مواطن يحبّ الله أن يُذكر فيها، فأنا أحبّ أن يدعى لي حيث يحبّ الله أن يُدعى فيها، والحائر من تلك المواضع».
[593] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، الطوسي، ص317، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص221. جاء نصّه: عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمد÷، يقولان: إنّ الله (تعالى) عوّض الحسين× من قتله أن جعل الإمامة في ذرّيته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تُعدّ أيّام زائريه جائياً وراجعاً من عمره.
[594] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص67، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص386. جاء نصّه: «عن عدى بن حرملة، عن عبد الله بن سليم والمذري، قالا: أقبلنا حتّى انتهينا إلى الصفاح، فلقينا الفرزدق بن غالب الشاعر، فواقف حسيناً، فقال له: أعطاك الله سؤلك وأمّلك فيما تحبّ، فقال له الحسين: بيّن لنا نبأ الناس خلفك، فقال له الفرزدق: مِن الخبير سألت، قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أُميّة، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء، فقال له الحسين: صدقت، لله الأمر، والله يفعل ما يشاء، وكلّ يوم ربّنا في شأن، إن نزل القضاء بما نحبّ، فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يعتد من كان الحقّ نيّته، والتقوى سريرته، ثمّ حرّك الحسين راحلته، فقال: السلام عليك. ثمّ افترقا».
[595] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف: ص155، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص388. جاء نصّه: «عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: لمّا خرجنا من مكّة، كتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى الحسين بن علي مع ابنيه عون ومحمد: أمّا بعد، فإنّى أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابي، فإنّي مشفق عليك من الوجه الذي توجّه له، أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك، إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض، فإنّك علم المهتدين، ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالسير، فإنّي في أثر الكتاب».
[596] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف: ص155، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص388. جاء نصّه: «قال وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص، فكلّمه وقال: اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه الأمان، وتمنّيه فيه البرّ والصلة، وتوثق له في كتابك، وتسأله الرجوع، لعلّه يطمئنّ إلى ذلك فيرجع، فقال عمرو بن سعيد: اكتب ما شئت، وأتني به حتّى أختمه، فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب، ثمّ أتى به عمرو بن سعيد، فقال له: اختمه وابعث به مع أخيك يحيى بن سعيد، فإنّه أحرى أن تطمئنّ نفسه إليه، ويعلم أنّه الجدّ منك، ففعل. وكان عمرو بن سعيد عامل يزيد بن معاوية على مكّة، قال: فلحقه يحيى وعبد الله بن جعفر، ثمّ انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الكتاب، فقالا: أقرأناه الكتاب، وجهدنا به، وكان ممّا اعتذر به إلينا أن قال: إنّي رأيت رؤيا، فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأُمرت فيها بأمر أنا ماض له، عليّ كان أولى، فقالا له: فما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدّثت أحداً بها، وما أنا محدّث بها حتّى ألقى ربّى.
قال: وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علي، أمّا بعد، فإنّى أسأل الله أن يصرفك عمّا يوبقك، وأن يهديك لما يرشدك، بلغني أنّك قد توجّهت إلى العراق، وإنّي أعيذك بالله مِن الشقاق، فإنّي أخاف عليك فيه الهلاك، وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد، فأقبل إلىَّ معهما، فإنّ لك عندي الأمان والصلة والبّر وحسن الجوار لك، الله علىّ بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل، والسلام عليك».
[597] اُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى، وقعة الطف: ص155، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص388. جاء نصّه: «قال: وكتب إليه الحسين: أمّا بعد، فإنّه لم يشاقق الله ورسوله مَن دعا إلى الله،} وعمل صالحاً، وقال إنّني من المسلمين، وقد دعوت إلى الأمان والبرّ والصلة، فخير الأمان أمان الله، ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا، فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة، فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبرّى، فجزيت خيراً في الدنيا والآخرة، والسلام».
[598] الشقاق، أي: شقّ الشيء إلى قسمين، فكما أنّ السيل يحدث في قلب الجبل وادياً، ويشقّ الجبل نصفين، فقد يُعبّر بهذا التعبير (شقّ عصا المسلمين) ويراد به الاختلاف والفرقة بين المسلمين، وقد جاء في الكتاب: (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﭜﭝ) (الحشر: آية4).
[599] فصّلت: آية33.
[600] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص388ـ389.
[601] الزمر: آية17ـ18.
[602] فصّلت: آية33.
[603] يوسف: آية108.
[604] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص127.
[605] فصّلت: آية33.
[606] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص388.
[607] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص132.
[608] نفس المصدر: ج2، ص132.
[609] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص269ـ270.
[610] الديلمي، الحسن بن علي، إرشاد القلوب: ج2، ص294، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج27، ص116.
[611] الحنفي القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ج3، ص60، ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص40.
[612] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص65، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص364.
[613] الفتّال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ج1، ص177.
[614] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص75ـ77، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص369ـ370.
[615] الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص193.
[616] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص686.
[617] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329.
[618] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص61.
[619] البقرة: آية156.
[620] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص82. جاء نصّه: «فقال عقبة بن سمعان: سرنا معه ساعة، فخفق وهو على ظهر فرسه خفقة، ثمّ انتبه، وهو يقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين، ففعل ذلك مرّتين أو ثلاثاً، فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين÷ على فرس، فقال: ممّ حمدت الله واسترجعت؟ فقال: يا بني، إنّي خفقت خفقة، فعن لي فارس على فرس، وهو يقول: القوم يسيرون، والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنّها أنفسنا نُعيت إلينا، فقال له: يا أبت _لا أراك الله سوء_ ألسنا على الحقّ؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد، قال: فإنّنا _إذاً_ لا نبالي أن نموت محقّين، فقال له الحسين×: جزاك الله مِن ولد خير ما جزى ولداً عن والده».
[621] كانت طوعة جارية، ثمّ أصبحت أُمّ ولد وتحرّرت (اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص54) ولم تكن طوعة من حرائر أهل الكوفة ونسائها، فهي كفضّة التي تربّت في بيت النبوّة وبيت الإمامة، ومَن ربّاها وعلّمها لديه ارتباط وأنس بالملكوت، وقد ربّت السيّدة زينب‘ عدّة سنين في الكوفة وخرجت أمثال هذه النساء، ولمّا أصبح أمير المؤمنين× خليفة المسلمين، واتخذ الكوفة عاصمة لحكومته، كان أولاده من فاطمة الزهراء‘ يُدرّسون العلوم الدينيّة وكان لديهم تلامذة، والسيّدة زينب‘ كان لها مجلس تحضر فيه النساء؛ ليتعلّمن المعارف الدينيّة في مجلسها ومدرستها، وطوعة وغيرها من النساء نموذج واضح من النساء الآتي تخرجن من هذه المدرسة الزينبيّة، فإن كانت السيّدة فضّة قد نالت منزلة لدخولها في سورة (هَلْ أَتَى) (الإنسان آية1) لمجرّد محبّتها لأهل البيت^، فما صنعته طوعة لم يكن عملاً بسيطاً، بل كان فيه خطورة، وقد يودي بحياتها.
[622] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص54، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص371.
[623] السيّدة زينب‘ هي أُخت الحسين بن علي×، كانت مأنوسة بالملكوت، وهذه القصّة سمعناها مكرراً، وهي انّ الإمام الحسين× هوّمت عيناه، ثمّ انتبه وقال: (ﭳﭴﭵﭶﭷ) (البقرة: آية156) فسأله علي الأكبر: يا أبه ممّا... استرجعت؟ فقال: يا بني، إنّي خفقت خفقة فاخبروني: أنَّ القوم يسيرون، والمنايا تسير إليهم... فقال له: ... ألسنا على الحقّ؟ قال: بلى... قال: فإنّنا إذاً لا نبالي أن نموت محقّين (المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص82). وشبيه بهذا الحدث ورد بشأن السيّدة زينب‘، فإنّه لمّا تحرّك أبو عبد الله× من مكّة متّجهاً نحو العراق، كان يستريح أحياناً في المنازل المتوفّرة عادة في الطريق، وكان ينصب خيامه في الأماكن التي تتمتّع بالماء والهواء المناسب، ويبقون فيها يوماً وليلة، وقد نزلوا في موضع خزيمة يوماً وليلة، وهو موضع يقع بعد الثعلبيّة، ويُنسب إلى خزيمة، فجاءت السيّدة زينب صبيحة تلك الليلة إلى أبي عبد الله×، فقالت له: قد خرجت البارحة من المخيّم لبعض الأعمال، فسمعت هاتفاً أنشأ يقول:
|
ألا يا عين فاحتفلي بجهد ومن يبكي على الشهداء بعدي إلى قوم تسوقهم المنايا بمقدار إلى إنجاز وعـــــــد |
(ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص95. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص372).
فهذا الهاتف هو ذلك الهاتف الملكوتي الذي لا تسمعه الأذن الجسمانيّة، وإلّا لسمعه الآخرون، فهذا السماع لم يكن في النوم، وإنّما في حالة بين النوم واليقظة، كما أنّ أغلب حالات الإمام الحسين× هي من قبيل حالة الخفقة، وهذا نظير ما حدث له في الطريق، وكذا يوم تاسوعاء وظهر عاشوراء، فقد قال: إنّي رأيت في المنام، فغنّ تلك الرؤيا في حالة الخفقة، وكان في حالة اليقظة لا النوم، وهذه الحالة هي ارتباط مباشر بملكوت هذا العالم، وزينب‘ قد سمعت ذلك الهاتف حينما باتوا تلك الليلة في خزيمة، وكما كان الإمام الحسين× يُخبر عن عالم الملكوت، كذلك السيّدة زينب‘ لم تكن منقطعة الصلة عن الملكوت، فلمّا أخبرت أبا عبد الله الحسين× بذلك الهاتف، قال×: «كلّ الذي قضى فهو كائن» (اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص372). نعم، هذا الارتباط بعالم الملكوت، قد ورثاه وتربّيا عليه من الصدّيقة فاطمة الزهراء‘ التي كانت مطّلعة على الملكوت.
[624] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص41.
[625] اُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص291.
[626] اُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص305، المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص61. وطبقاً لبعض الأخبار: أنّه لمّا أراد مسلم أن يوصي، هناك جماعة قد صرفوا بوجوههم عنه، إرضاء للأمراء الأُمويين القذرين. جاء في الإرشاد: «قال: فدعني أوصي إلى بعض قومي، قال: افعل، فنظر مسلم إلى جلسائه، وفيهم عمر بن سعد بن أبي وقّاص، فقال: يا عمر، إنّ بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة، وقد يجب لي عليك نجح حاجتي وهي سرّ، فامتنع عمر أن يسمع منه، فقال له عبيد الله: لمَ تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمّك؟ فقام معه، فجلس حيث ينظر إليهما ابن زياد، فقال له: إنّ عليّ ديناً بالكوفة ،استدنته منذ قدمت الكوفة سبعمائة درهم، فاقضها عني، وإذا قُتلت فاستوهب جثّتي من ابن زياد فوارها، وابعث إلى الحسين مَن يردّه، فإنّي قد كتبت إليه أعلمه أنّ الناس معه، ولا أراه إلّا مقبلاً... »
[627] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص98.
[628] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص363. جاء نصّه : «... فلمّا كان من العشى، أقبل عبيد الله لعيادة شريك، فقام مسلم بن عقيل ليدخل، وقال له شريك: لا يفوتنّك إذا جلس، فقام هانئ بن عروة إليه، فقال: إنّى لا أحبّ أن يُقتل في داري، كأنّه استقبح ذلك، فجاء عبيد الله بن زياد، فدخل فجلس، فسأل شريكاً عن وجعه، وقال: ما الذي تجد ومتى أشكيت؟ فلمّا طال سؤاله إيّاه، ورأى أنّ الآخر لا يخرج، خشى أن يفوته، فأخذ يقول: ما تنظرون بسلمى أن تحيّوها، أسقنيها وإن كانت فيها نفسي، فقال ذلك مرّتين أو ثلاثاً، فقال عبيد الله _ولا يفطن_: ما شأنه أترونه يهجر؟ فقال له هانئ: نعم، أصلحك الله، ما زال هذا ديدنه قبيل عماية الصبح حتّى ساعته هذه، ثمّ إنّه قام فانصرف، فخرج مسلم، فقال له شريك: ما منعك من قتله؟ فقال: خصلتان، أمّا إحداهما فكراهة هانئ أن يُقتل في داره، وأمّا الأخرى فحديث حدّثه الناس عن النبي’: إنّ الإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن، فقال هانئ: أما _والله_ لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراً، ولكن كرهت أن يُقتل في داري...».
[629] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص60ـ61. جاء نصّه: «فأخذ كلّما شرب امتلأ القدح دماً من فيه، فلا يقدر أن يشرب، ففعل ذلك مرّة ومرّتين، فلمّا ذهب في الثالثة ليشرب سقطت ثنايتاه في القدح، فقال: الحمد لله، لو كان لي من الرزق المقسوم شربته».
[630] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص62. جاء نصّه: «فقال له ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق؟ لمَ لم تعمل فيهم بذاك، إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟ قال: أنا أشرب الخمر؟! أم _والله_ إنّ الله ليعلم أنّك تعلم أنّك غير صادق، وأنّك قد قلت بغير علم، وأنّي لست كما ذكرت، وأنّك أحقّ بشرب الخمر منّي...».
[631] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص59. جاء نصّه: «وبكى، فقال له عبيد الله ابن العباس السلمي: إنّ مَن يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم يبك، قال: إنّي _والله_ ما لنفسي بكيت، ولا لها من القتل أرثي، وإن كنت لم أحبّ لها طرفة عين تلفاً، ولكن أبكي لأهلي المقبلين إليّ، أبكي للحسين× وآل الحسين».
[632] نفس المصدر: ص58.
[633] إبراهيم: آية1.
[634] المقرّم، عبد الرزاق، مقتل الحسين×: ص165.
[635] الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص441.
[636] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص63.
[637] اُنظر: نفس المصدر: ج2، ص74، 75. جاء نصّه «وأنّه حدّثنا أنّه لم يخرج من الكوفة حتّى قتل مسلم وهانئ، ورآهما يجرّان في السوق بأرجلهما، فقال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، رحمة الله عليهما، يكرّر ذلك مراراً ...، فنظر إلى بني عقيل فقال: ما ترون؟ فقد قُتل مسلم، فقالوا: والله لا نرجع حتّى نصيب ثأرنا أو نذوق ما ذاق...».
[638] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص83ـ88.
[639] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص84، الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص337.
[640] الراوندي، سعيد بن عبد الله، الخرائج والجرائح: ج1، ص183، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج41، ص295.
[641] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص326.
[642] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص422.
[643] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص383.
[644] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص83.
[645] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص412.
[646] اُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص346.
[647] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص83.
[648] اُنظر: نفس المصدر: ج2، ص84.
[649] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص393، الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص15.
[650] العيوق: هو أحد نجوم السماء يزعم علماء الفلك أنّ له دوراً في هطول الأمطار.
[651] المحتشم الكاشاني، علي بن أحمد، ديوان أشعار المحتشم الكاشاني: ص323. ويصف الشاعر صوت الأطفال الذين ينادون العطش العطش في صحراء كربلاء ويقول :إنّ تلك الأصوات لا زالت تصل إلى عيوق السماء.
[652] اُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص346ـ347.
[653] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص84.
[654] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص412.
[655]المسافة بين الكوفة وكربلاء مسيرة يوم، وكانت الرسل السريعة تصل من الكوفة الى كربلاء خلال يوم واحد وترجع خلال يوم واحد.
[656] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص90. جاء نصّه: «أختاه، إنّي رأيت الساعة جدّي محمد| وأبى علياً وأمّي فاطمة الزهراء وأخي الحسن، وهم يقولون: يا حسين، إنّك رائح إلينا عن قريب _وفى بعض الروايات: غداً_ قال الراوي: فلطمت زينب وجهها، وصاحت وبكت، فقال لها الحسين: مهلاً، لا تشمتي القوم بنا».
[657] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص147. جاء نصّه: « عن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله× عن صوم تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرّم؟ فقال: تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين× وأصحابه رضي الله عنهم بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام، وأناخوا عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بنوافل الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين× وأصحابه كرّم الله وجوههم، وأيقنوا أن لا يأتي الحسين× ناصر، ولا يمدّه أهل العراق، بأبي المستضعَف الغريب، ثمّ قال: وأمّا يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين× صريعاً بين أصحابه، وأصحابه صرعى حوله، أفصوم يكون في ذلك اليوم؟! كلّا وربّ البيت الحرام، ما هو يوم صوم، وما هو إلّا يوم حزن ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين...».
[658] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص88.
[659] اُنظر: نفس المصدر: ج2، ص89، الطبرسي، الفضل بن الحسين، إعلام الورى: ص237.
[660] لحسن العاقبة أهمّية بالغة، فقد كان الشمر هذا يضرب بسيفه في سبيل الإسلام، ولكنّه اليوم أصبح بهذا الشكل، وكذلك طلحة والزبير ابتلوا بنفس المشكلة، ولذا ينبغي أن نسأل الله تعالى حسن العاقبة.
[661] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص89، الطبرسي، الفضل بن الحسين، إعلام الورى: ص237..
[662] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص216ـ417. جاء نصّه: «وقف أصحابه يخاطبون القوم، فقال حبيب بن مظاهر... أما _والله_ لبئس القوم عند الله غداً قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرّية نبيّه’ وعترته وأهل بيته^، وعبّاد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار، والذاكرين الله كثيراً، فقال له عزرة ابن قيس: إنّك لتزكّى نفسك ما أستطعت، فقال له زهير: يا عزرة، إنّ الله قد زكّاها وهداها...».
[663] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص90ـ91 واُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسين، إعلام الورى: ص237. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص391ـ392. وهذه العبارة القيّمة لم تصدر من سيّد الشهداء× حتّى بحقّ أولاده.
[664] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص89. جاء نصّه: «قال الراوي: فسألهم العباس ذلك، فتوقّف عمر بن سعد، فقال عمرو بن الحّجاج الزبيدي: والله، لو أنّهم من الترك والديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم، فكيف وهم من آل محمد|، فأجابوهم إلى ذلك».
[665] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص89، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص391. ما ورد في الكتاب الأخير الذي جاء به الشمر من الكوفة: «وكتب إلى عمر بن سعد: إنّي لم أبعثك إلى الحسين لتكفّ عنه، ولا لتطاوله، ولا لتمنّيه السلامة والبقاء، ولا لتعتذر له، ولا لتكون له عندي شافعاً، اُنظر فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا، فابعث بهم إليّ سلماً، وإن أبوا، فازحف إليهم حتّى تقتلهم وتمثّل بهم، فإنّهم لذلك مستحقّون، وإن قُتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره، فإنّه عات ظلوم، وليس أرى أنّ هذا يضرّ بعد الموت شيئاً، ولكن عليَّ قول قد قلته: لو قتلته لفعلت هذا به، فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندنا، وخلّ بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإنّا قد أمّرناه بأمرنا، والسلام» وبعد أن وصل هذا الكتاب «نادى عمر بن سعد: يا خيل الله، اركبي وابشري، فركب الناس، ثمّ زحف نحوهم بعد العصر».
[666] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص90ـ91.
[667] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص147.
[668] نفس المصدر: ج4، ص147.
[669] لم يكن العدو يقصد قتل أبي عبد الله الحسين× فحسب، بل كان ينوي قتله أو يأخذه أسيراً، ولذا كان الإمام× لا يمنع من تفرّق أصحابه، وكان جادّاً في إعطاء الرخصة لهم، وعدم وجود ذمّة بينه وبينهم؛ لأنّ الإمام وليّ أمر المسلمين، ونصرته حقّ عليهم، وقد سمح لهم بالانصراف، ولأنّ نهاية هذا الأمر هو شهادة الحاضرين في كربلاء، سواء بقى الأصحاب أو انصرفوا.
[670] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص91.
[671] نفس المصدر: ج2، ص91.
[672] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص215ـ216.
[673] الخصيبي، حسين بن حمدان، الهداية الكبرى: ص204، البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص215.
[674] الخصيبي، حسين بن حمدان، الهداية الكبرى: 205، البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص215ـ 216.
[675] الأربلي، علي بن عيسى، كشف الغمّة: ج2، ص25.
[676] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص462.
[677] المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص226.
[678] نفس المصدر: ص226ـ227. جاء فيه «فلمّا سمع هلال ذلك، بكى رقّة ورجع، وجعل طريقه على منزل حبيب بن مظاهر، فرآه جالساً وبيده سيف مصلَت، فسلّم عليه وجلس على باب الخيمة، ثمّ قال له: ما أخرجك يا هلال؟ فحكيت له ما كان، فقال: إي والله، لولا انتظار أمره لعاجلتهم، وعالجتهم هذه الليلة بسيفي، ثمّ قال هلال: يا حبيبي، فارقت الحسين× عند أخته، وهي في حال وجل ورعب، وأظنّ أنّ النساء أفقن وشاركنها في الحسرة والزفرة، فهل لك أن تجمع أصحابك وتواجهنّ بكلام يسكّن قلوبهنّ ويذهب رعبهنّ، فلقد شاهدت منها ما لا قرار لي مع بقائه، فقال له: طوع إرادتك، فبرز حبيب ناحية وهلال إلى جانبه، وانتدب أصحابه، فتطالعوا من منازلهم، فلمّا اجتمعوا، قال لبني هاشم: ارجعوا إلى منازلكم، لا سهرت عيونكم، ثمّ خطب أصحابه، وقال: يا أصحاب الحميّة، وليوث الكريهة، هذا هلال يخبرني الساعة بكيت وكيت، وقد خلّف أخت سيّدكم وبقايا عياله يتشاكين ويتباكين، أخبروني عمّا أنتم عليه. فجرّدوا صوارمهم، ورموا عمائمهم، وقالوا: يا حبيب، أما والله الذي منّ علينا بهذا الموقف، لئن زحف القوم لنحصدنّ رؤوسهم ،ولنلحقنّهم بأشياخهم أذلاّء صاغرين، ولنحفظنّ وصيّة رسول الله’ في أبنائه وبناته. فقال: هلمّوا معي، فقام يخبط الأرض وهم يعدون خلفه، حتّى وقف بين أطناب الخيم، ونادى: يا أهلنا، ويا ساداتنا، ويا معاشر حرائر رسول الله، هذه صوارم فتيانكم، آلوا أن لا يغمدوها إلّا في رقاب من يبتغي السوء فيكم، وهذه أسنّة غلمانكم، أقسموا أن لا يركزوها إلّا في صدور من يفرق ناديكم...».
[679] المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين: ص226ـ227. أي: إنّ هؤلاء الأصحاب هم تلامذة علي×، وأنّ الفكر العلوي هو المهيمن عليهم، حيث يقول: «والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أُمّه» (الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة5. كما أنّ أصل هذه القضيّة منقولة عن علي ابن أبي طالب×.
[680] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص95.
[681] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص157. جاء فيه: «ثمّ قال لأصحابه: قُوموا فاشْرَبوا مِن الْماء يَكُن آخِر زادِكم، وَتَوَضَّأوا وَاغْتسلوا، وَاغْسِلُوا ثِيابَكم لِتَكُونَ أَكْفانَكُم».
[682] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص94. جاء فيه: «وبات الحسين× وأصحابه تلك الليلة ولهم دويّ كدويّ النحل، ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد».
[683] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص100.
[684] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص95.
[685] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص439.
[686] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص439، الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج2، ص20.
[687] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص107، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص20، الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص436. جاء نصّه: «ثمّ خرج مسلم بن عوسجة، فبالغ في قتال الأعداء، وصبر على أهوال البلاء حتّى سقط إلى الأرض وبه رمق، فمشى إليه الحسين× ومعه حبيب بن مظاهر، فقال له الحسين: رحمك الله يا مسلم (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) ودنا منه حبيب، وقال: عزَّ علىَّ مصرعُك يا مسلم، أبشر بالجنّة، فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: بشّرك الله، ثمّ قال له حبيب: لولا أنّني أعلم أنّى في الأثر، لأحببت أن توصي إلىّ بكلّ ما أهمّك، فقال له مسلم: فإنّي أوصيك بهذا _وأشار إلى الحسين×_ فقاتل دونه حتّى تموت، فقال له حبيب: لأنعمنّك عيناً، ثمّ مات، رضوان الله عليه».
[688] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص106ـ107، الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين: ج2، ص18، 22.
[689] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص463.
[690] اُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص318.
[691] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص463. جاء نصّه: «أتاه الحسين× ودمه يشخب، فقال: بخ بخ يا حرّ، أنت حرّ كما سُمّيت في الدنيا والآخرة».
[692] اُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص251. جاء نصّه: «لمِا نُقل في كتب السير والتواريخ أنّ تلك العصابة هي دسمال الحسين×، شدّ به رأس الحرّ لمّا أُصيب في تلك الواقعة، ودُفن على تلك الهيئة».
[693] اُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص256.
[694] لأنّ الرسل العسكريّة لا يمكنهم أن يسلكوا الطريق العام، بل يضطرّون إلى تنكب الطريق، خشية إلقاء القبض عليهم، وانكشاف ما في الكتب من الأسرار العسكريّة، فالإمام× اختار مسلم بن عقيل ممثّلاً عنه، وأرسله إلى الكوفة، وأوصل سعيد _مرّة أخرى_ هذا الكتاب من مكّة إلى الكوفة، وعليه فتمّ قطع ستمائة فرسخ، ثمّ أُرسل للمرّة الثالثة بكتاب مسلم بن عقيل وأخبار الكوفة إلى مكّة، وسلّمه بيد الإمام×، فأصبحت المسافة التي قطعها ستمائة فرسخ، وأمّا المرّة الرابعة فقد جاء من مكّة مع ركب الإمام الحسين× إلى كربلاء، فيكون المجموع ألف وستمائة فرسخ، لذا فقد أراد أن يحظى بهذا الفخر والشرف، ويقف أمام الحسين×، ويقيه السهام بنفسه
[695] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص111.
[696] المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص256. جاء نصّه: «ولمّا اثخن سعيد بالجراح، سقط إلى الأرض، وهو يقول: اللهمّ العنهم لعن عاد وثمود، وأبلغ نبيّك منّي السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فغنّي أردت بذلك ثوابك في نصرة ذرّية نبيّك، والتفت إلى الحسين، قائلاً: أَوَفيت يا بن رسول الله؟ قال: نعم، أنت أمامي في الجنّة، وقضى نحبه. فوُجد فيه ثلاثة عشر سهماً، غير الضرب والطعن».
[697] اُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين: ص263. جاء نصّه: «وكان أنس بن الحارث بن نبيه الكاهلي شيخاً كبيراً، وصحابيّاً رأى النبي وسمع حديثه، وشهد معه بدراً وحنيناً، فاستأذن الحسين، وبرز شادّاً وسطه بالعمامة، رافعاً حاجبيه بالعصابة، ولمّا نظر إليه الحسين بهذا الهيئة بكى، وقال: شكر الله لك يا شيخ. فقتل _على كبره_ ثمانية عشر رجلاً، وقتل».
[698] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص114.
[699] اُنظر: دیوان خوشدل تهرانی: ص759. ذكر الشاعر: أنّ الإمام الحسين× ساوى بين ولده علي الأكبر وبين الغلام الأسود فقبّل خديهما معاً معلناً بذلك أنّ دينه لا يفرّق بين الأسود والأبيض.
[700] اُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص263. جاء نصّه: «ووقف جون مولى أبي ذر الغفاري أمام الحسين يستأذنه، فقال×: يا جون، إنّما تبعتنا طلباً للعافية، فأنت في إذن منّي، فوقع على قدميه يقبّلهما، ويقول: أنا في الرخاء ألحس قصاعكم، وفي الشدّة أخذلكم! إنّ ريحي لنتن، وحسبي للئيم، ولوني لأسود، فتنفّس عليّ بالجنّة؛ ليطيب ريحي، ويشرف حسبي، ويبيض لوني، لا _والله_ لا أفارقكم حتى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم. فأذن له الحسين، فقتل خمساً وعشرين وقُتل، فوقف عليه الحسين، وقال: اللهمّ بيّض وجهه، وطيّب ريحه، واحشره مع محمد|، وعرّف بينه وبين آل محمد’. فكان مَن يمرّ بالمعركة يشمّ منه رائحة طيّبة أذكى من المسك».
[701] اُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج4، ص56.
[702] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص106، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص321.
[703] استرجع، أي: قال: (ﭳﭴﭵﭶﭷ) (البقرة: آية156).
[704] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص82.
[705] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: ص91، خطبة55.
[706] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص713.
[707] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص113.
[708] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار الكبير: ص487.
[709] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص97.
[710] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص35، ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص113.
[711] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص35، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص43.
[712] الحسيني الحائري، محمد، تسلية المجالس وزينة المجالس: ج2، ص312.
[713] أبو الفرج الإصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص81.
[714] الحسيني الحائري، محمد، تسلية المجالس وزينة المجالس: ج2، ص113.
[715] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص114.
[716] التبريزي، محمد رفيع، ذريعة النجاة: ص230.
[717] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك (تاريخ الطبري): ج5، ص447.
[718] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك، (تاريخ الطبري): ج5، ص447.
[719] آل عمران: آية33ـ34.
[720] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص35. وقد استجاب الله تعالى دعاء الإمام×، وذلك لمّا حدثت ثورة المختار، سلّط الله عليه من يذبحه على فراشه.
[721] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص108، ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص116.
[722] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص108، ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص116.
[723] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص1110، ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص122.
[724] الشريعة: أو (مورد الشاربة) هو مكان على ضفّة النهر، له منحدر يسير بواسطته يتمكّن الناس من الحصول على الماء. «مَشْرَعةُ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربةِ التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها ويَسْتَقُونَ» (ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج8، ص175).
[725] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص41.
[726] اُنظر: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: الكتاب45، فقرة10ـ12.
إنَّ الإمام أمير المؤمنين× كان لديه إمكانيّة ماليّة جيّدة، قد حاز عليها بعمله وجهوده وما تحمّله من عناء، فكان من المتمكّنين في المدينة، فإنّه توجّه في الفترة التي أصبح فيها جليس البيت إلى الزراعة، وكان له سهم من غنائم دار الحرب، ويستلم ممّا خُصّص لمسؤولي النظام الإسلامي، وبناء على هذا فالإمام× لم يكن يعاني من ضيق مالي، فقد وقف مزارع كثيرة؛ لكنّ السرّ في الحياة البسيطة والعجيبة لذلك الإمام الهمام هو أنّ الإمام× كان يعيش في عصر يعاني فيه المجتمع الإسلامي من الفقر، وعلى القادة الإسلاميين أن يعيشوا حياة المحتاجين.
نعم، إنّ الأوضاع قد تغيّرت بعد قوّة الإسلام وانتصاره وفتحه إيران والروم، وأصبحت أكثر مناطق آسيا الوسطى إلى قلب فرنسا تحت سلطة الإسلام.
ففي ذلك العصر أصبح أبرز معسكرين وأقوى إمبراطوريّتين (إيران والروم) ـ فكانت حكومة إيران الملكية لا تقتصر على أخذها الخراج من رعاياها فقط، بل كان الإمبراطور يأخذ الخراج من الدول الصغيرة المجاورة أيضاً ـ تحت سلطة الحجاز، وأخذت تذهب ثرواتهما إلى الحجاز، وبخلاف الحال التي كانت في عصر علي بن أبي طالب× حيث كان الفقر هو الحاكم.
ومن المناسب الإشارة هنا إلى حادثة، وهي حادثة مخجلة لنا حقيقة، قال صاحب كتاب الغارات _وهو كتاب قد أُلّف قبل نهج البلاغة بقرن، وهو كتاب يُبيّن غارات الأُمويين في الحكومة العلويّة، ويروي كلمات وخطب وكتب الإمام علي× بمناسبة هجوم وغارات الأُمويين في الحكومة العلويّة_ حيث يروي فيه عن بعض مشايخه، وعن أستاذه، قال: «حدّثنا محمد، حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا إبراهيم، قال: أخبرني الحسين بن هاشم، عن أبي عثمان الدوري، عن أبي إسحاق السبيعي، قال: كنت على عنق أبي يوم الجمعة، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ× ـ يخطب، وهو يتروح بكمّه، فقلت: يا أبه، أمير المؤمنين يجد الحرّ؟ فقال لي: لا يجد حرّاً ولا برداً، ولكنّه غسل قميصه وهو رطب، ولا له غيره، فهو يتروح به» (ابن هلال الثقفي، إبراهيم بن محمد، الغارات: ج1، ص62).
وقد قال أمير المؤمنين× في بيان السرّ في بساطة حياته: «إنّ الله ـ تعالى ـ فرض على أئمّة العدل أن يقدّروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا...» (الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة209) نعم، فحينما يرى الفقير إمام المسلمين يعيش مثله، عيشاً بسيطاً متواضعاً يهدأ، وإلّا فإنّه يثور.
وقد ورد في الفقه الإسلامي: أنّه يجب على إمام الجماعة أن يراعي أضعف المأمومين (اُنظر: العلّامة الحلّي، حسن بن يوسف، منتهى المطلب: ج6، ص304ـ305، البحراني، يوسف بن أحمد، الحدائق الناضرة: ج11، ص171ـ173) على الإمام أن يراعي أضعف المأمومين.
[727] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص41.
[728] بناء على التعاليم الدينيّة، لا ينبغي للأب أن يأكل خارج البيت طعاماً جيّداً، والحال أنّ أبناءه جائعون ينتظرونه.
[729] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص108، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص42.
[730] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص299. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج42، ص59.
[731] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص179.
[732] اُنظر: الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص404.
[733] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص181.
[734] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص42.
[735] اُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص336ـ337.
[736] المقرّم، عبد الرزاق، مقتل الحسين×: ص336ـ337.
[737] الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص209.
[738] بالرغم من أنّه قيل: إنّ ليلى لم تأت إلى كربلاء، إلّا أنّه قد ورد في هذه الرواية حضورها في كربلاء.
[739] الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص208ـ 209.
[740] بالرغم من أنّ الإمام× كان بإمكانه أن يأتي بالجواد بنفسه، وكان غير أبي الفضل من بني هاشم حاضراً _أيضا_ لكنّ المنصب العسكري والإداري للإمام الحسين× يحتمّ على الإمام الحسين× أن يطلب من أبي الفضل الإتيان بالجواد، فهذا العمل يصدر من القائد العسكري لأجل تثبيت منصبه العسكري.
[741] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار الكبير: ص504، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص322.
[742] الفاضل الدربندي، ابن عابد، إكسير العبادات: ج2، ص627ـ629.
[743] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص90ـ91، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص393.
[744] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص90، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص392ـ393.
[745] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص90.
[746] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص462، 463.
[747] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص256ـ257.
[748] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص574.
[749] البهبهاني، محمد باقر، الدمعة الساكبة: ج4، ص256.
[750] اُنظر: الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج5، ص411.
[751] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص215ـ216.
[752] المقصود به علي الأكبر.
[753] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص108.
[754] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص117، الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص37.
[755] الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص389.
[756] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص117.
[757] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص117.
[758] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص574.
[759] فاطر: آية10.
[760] الحجّ: آية37.
[761] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص238ـ239. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص133. جاء نصّه: «عن المنهال بن عمرو، قال: دخلت على علي بن الحسين÷ منصرفي من مكّة، فقال لي: يا منهال، ما صنع حرملة بن كاهلة الأسدي؟ فقلت: تركته حيًّا بالكوفة، قال: فرفع يديه جميعاً، فقال: اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه حرّ النار. قال المنهال: فقدمت الكوفة، وقد ظهر المختار بن أبي عبيد، وكان لي صديقاً، قال: فكنت في منزلي أيّاماً حتّى انقطع الناس عنّي، وركبت إليه، فلقيته خارجاً من داره، فقال: يا منهال، لم تأتنا في ولايتنا هذه، ولم تهننا بها، ولم تشركنا فيها؟ فأعلمته أنّي كنت بمكّة، وأنّي قد جئتك الآن، وسايرته ونحن نتحدّث حتّى أتى الكناس، فوقف وقوفاً كأنّه ينتظر شيئاً، وقد كان أخبر بمكان حرملة بن كاهلة، فوجّه في طلبه، فلم نلبث أن جاء قوم يركضون، وقوم يشتدون، حتّى قالوا: أيّها الأمير، البشارة، قد أُخذ حرملة بن كاهلة، فما لبثنا أن جئ به، فلّما نظر إليه المختار، قال لحرملة: الحمد لله الذي مكّنني منك. ثمّ قال: الجزّار الجزّار، فأتي بجزّار، فقال له: اقطع يديه، فقطعتا، ثمّ قال له: اقطع رجليه، فقطعتا، ثمّ قال: النار النار، فأُتي بنار وقصب، فألقي عليه واشتعلت فيه النار. فقلت: سبحان الله، فقال لي: يا منهال، إنّ التسبيح لحسن، ففيم سبّحت؟ فقلت: أيّها الأمير، دخلت في سفرتي هذه _منصرفي من مكّة_ على علي بن الحسين÷، فقال لي: يا منهال، ما فعل حرملة بن كاهلة الأسدي؟ فقلت: تركته حيّاً بالكوفة، فرفع يديه جميعاً فقال: اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه حرّ النار. فقال لي المختار: أسمعت علي بن الحسين÷ يقول هذا؟ فقلت: والله، لقد سمعته، قال، فنزل عن دابّته وصلّى ركعتين، فأطال السجود، ثمّ قام فركب، وقد احترق حرملة، وركبت معه وسرنا، فحاذيت داري، فقلت: أيّها الأمير، إن رأيت أن تشرّفني وتكرّمني وتنزل عندي، وتحرم بطعامي. فقال: يا منهال، تعلمني أنّ علي بن الحسين دعا بأربع دعوات، فأجابه الله على يديّ، ثمّ تأمرني أن آكل! هذا يوم صوم شكراً لله} على ما فعلته بتوفيقه.
[762] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص301، الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص37. جاء نصّه: «ناولوني ذلك الطفل حتّى أودّعه، فناولوه الصبي، جعل يقبّله، وهو يقول: يا بنيّ، ويل لهؤلاء القوم، إذا كان خصمهم محمد|، قيل: فإذا بسهم قد أقبل حتّى وقع في لبة الصبي فقتله، فنزل الحسين عن فرسه، وحفر للصبي بجفن سيفه، ورمله بدمه ودفنه».
[763] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص108. جاء نصّه: «ثمّ جلس الحسين× أمام الفسطاط، فأُتي بابنه عبد الله بن الحسين، وهو طفل، فأجلسه في حجره، فرماه رجل من بني أسد بسهم فذبحه، فتلقّى الحسين× دمه، فلمّا ملأ كفّه صبّه في الأرض، ثمّ قال: رب إن تكن حبست عنّا النصر من السماء، فاجعل ذلك لما هو خير، وانتقم لنا من هؤلاء القوم الظالمين، ثمّ حمله حتّى وضعه مع قتلى أهله».
[764] البهبهاني، محمد باقر، الدمعة الساكبة: ج4، ص374.
[765] إنّ هذا الطفل هو أخو سكينة‘، حيث إنّ هذا الأخ والأخت من أمة واحدة، عبد الله بن الحسين هو علي الأصغر أخو سكينة، وقد ورد في الزيارة الناحية المقدّسة، سلام الإمام صاحب الزمان# بعنوان الطفل الرضيع. (اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص574).
[766] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص117.
[767] اُنظر: المحقّق الحلّي، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام: ج1، ص283، النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام: ج21، ص81.
[768] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص95ـ97.
[769] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص110ـ111.
[770] المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص290.
[771] إنّ الإمام سيّد الشهداء× قد ترك لنا خطبتين في معركة كربلاء غير المتكافئة، مشتملتين على مفاهيم العزّة والإباء، وبيت القصيد والمغزى فيهما ،هو قوله: «هيهات منّا الذلة».
فقد جاء في الخطبة الأولى: «قال لهم الحسين×: [بعد الحمد والثناء] فإن كنتم في شكّ من هذا، أفتشكّون أنّي ابن بنت نبيّكم؟ فوالله، ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ غيري فيكم، ولا في غيركم، ويْحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته [ وكان _قبل فترة_ ابن زياد تحت قبضة سيف مسلم بن عقيل _سفير الحسين×_ في الكوفة، وكان بإمكانه قتله، ولكنّه لم يفعل، ولو فعل لأصبح قميص ابن زياد كقميص عثمان]، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟!» (المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص98).
احتجّ عليهم بهذا القول في الخطبة الأولى، فاقترحوا عليه الاستسلام، فقال تلك الجملة الغرّاء: «لا والله، لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفرّ فرار العبيد، ... أعوذ بربي وربكم من كلّ متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» (المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص98). إنّي أعتمد على القدرة الأزليّة الإلهيّة، فالإمام الحسين× قال لزيد كما قال موسى الكليم لفرعون.
وأمّا في الخطبة الثانية، قد سلك الإمام× طريق العواطف، ولم يتعرّض إلى المسائل السياسيّة والفقهيّة والماليّة: «لمّا رآهم الحسين× مصرّين على قتله، أخذ المصحف ونشره، ونادى: بيني وبينكم كتاب الله وسنّة جدّي رسول الله|، بم تستحلّون دمي؟ ألست ابن بنت نبيّكم؟ ألم يبلغكم قول جدّي فيّ وفي أخي: هذان سيّدا شباب أهل الجنّة؟ إن لم تصدّقوني فاسألوا جابراً وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري، والله ما تعمّدت كذباً منذ علمت أنّ الله سبحانه عاقب عليه أهله، والله ما بين المشرق والمغرب ابن نبيّ غيري فيكم، ولا في غيركم». (سبط بن الجوزي، يوسف، تذكرة الخواص: ص227). فأراد الإمام× بواسطة نشر الكتاب على رأسه ليجعل الكتاب حكماً بينه وبينهم، ويستطيع من خلال ذلك استمالتهم من الناحية العاطفيّة كي لا يدخل ثلاثون ألف في نار جهنّم، ولا يسمح لأن يصبح نظام الإسلام بيد الأُمويّين والمروانيّين والعبّاسيين الذين هم سلسلة ملوك ألفين وخمسمائة عام.
وقد أراد الإمام الحسين× أن ترجع الخلافة إلى وضعها ومكانها الأصليّ، ولا تتحوّل إلى ملَكيّة وسلطنة، فقال: «بيني وبينكم كتاب الله» (سبط، ابن الجوزي، يوسف، تذكرة الخواص: ص227) فقالوا: لا طريق لك سوى الاستسلام، فرجع مرّة أخرى إلى بيت القصيد في خطبته الثانية يشبه بيت القصيد في الخطبة الأولى: «لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل» (المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص98) وهو «هيهات منّا الذلّة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهُرت، وأُنوف حميّة ونفوس أبيّة، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام» (ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص97ـ98).
ومن هنا يتبيّن دور المرأة في التربيّة، فدور المرأة كدور الرجل في تربية أصحاب الملاحم، ويظهر هذا المعنى جليّاً في خطبة سيّد الشهداء× الثانية، فأهل البيت^ قد أعطوا للمرأة حرمتها وقيمتها، يرون ضرورة احترامها وتقديرها، وهذه العقيدة لم تكن موجودة، لا في الماضي ولا يوجد ذلك في غير مدرسة أهل البيت^، وكلّما تحدّثنا عن كلام شخصيّات عظيمة، يأتي إلى جنب ذلك، الحديث حول نساء عظيمات صنعت ملاحم، والإمام السجّاد× قال على منبر الشام: «أنا ابن علي المرتضى...» ومن جانب آخر قال: «أنا ابن فاطمة الزهراء» (الحسيني، الحائري، محمد، تسلية المجالس وزينة المجالس: ج2، ص394ـ935، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص138ـ139) ولم يكن للمرأة في الجاهليّة وعند الأُمويّين قيمة، ولا حرمة، ولكنّ الإمام السجّاد× _الذي صنع الملاحم_ يفتخر بأنّه ابن فاطمة الزهراء‘.
[772] البحراني، عبد الله، عوالم العلوم: ج11، ص954.
[773] إنّ الذات الإلهيّة المقدسة تذكر أوصاف المؤمنين في القرآن، وأمّا الأوحديون منهم فينظر القرآن إليهم نظرة خاصّة، قال بشأن المؤمنين الكمّل: (لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) (النور: آية37) فالمؤمنون لا يلهيم البيع والتجارة عن ذكر الله، والأوحديون منهم هو مَن لا تلهيهم الحرب عن ذكر الله، حيث قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الأنفال: آية45).
فالآية (لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ) تتحدّث عن فئة متوسطة من الناس أي: الناس العدول والطيّبين، وأمّا مَن يذكر الله تعالى في الحرب، فمثاله البارز نجده في خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، حيث كان يُلقي خطبه عند اشتعال الحرب، والإمام× في الجهاد الأكبر عاشق وليس عادل فحسب، وأكثر خطبه التعليميّة كانت في الحروب، مثل: الجمل والنهروان وصفّين، فحينما يتكلّم الإنسان في المسجد، ليس هناك أيّ صعوبة، ولكن إذا كان في حالة الحرب فإنّه حينما يخطب لا يذكر إلّا الله والصبر والاستقامة، وهذا العمل عشق، لا عقل.
[774] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص157.
[775] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص67، ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص19.
[776] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص109. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: س123ـ124.
[777] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص109.
[778] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص67.
[779] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص93.
[780] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص47.
[781] نفس المصدر: ج45، ص46. الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص37.
[782] اُنظر: البهبهاني، محمد باقر، الدمعة الساكبة: ج4، ص352. وقد أوكل الإمام× الإجابة على الأحكام الشرعيّة إلى الإمام السجّاد×، ولكن لكي لا يُتعرّف عليه أنّه الإمام الرابع، ذكر الإمام× أنّ أمور القافلة يُرجع فيها إلى السيّدة زينب الكبرى‘ ويسألها، ومن هذه الناحية فزينب‘ تأخذ أحكامها من الإمام السجّاد×، والظاهر أنّها كانت تفتي بها، ولذا ظنّ بعضهم انّ مرجع الفتوى هي السيّدة زينب‘، وبناء على فتواها، عندما كان الناس في سوق الكوفة يعطون إلى الصبيان التمر والخبز؛ لأنّ الصدقة على أبناء رسول الله حرام، فكانت‘ تأخذ التمر من الأطفال (إنّ الصدقة علينا حرام) ولذا ورد: «يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوز، فصاحت بهم أمّ كلثوم، وقالت: يا أهل الكوفة: إنّ الصدقة علينا حرام». (المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص114)، فهنا الفتوى صدرت من الإمام زين العابدين×، ولكنّ الذي أعلن عنها السيّدة زينب الكبرى‘، وذلك حفظاً لحياة الإمام×.
[783] الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص448.
[784] اُنظر: نفس المصدر: ص448.
[785] سبط بن الجوزي، يوسف، تذكرة الخواص: ص227.
[786] القاضي الشوشتري، نور الله، إحقاق الحقّ: ج11، ص647.
[787] الطريحي، فخر الدين، المنتخب: ج1، ص220.
[788] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص120.
[789] اُنظر: الفاضل الدربندي، ابن عابد، إكسير العبادات: ج3، ص17. جاء نصّه: «إنّ الحسين× كان لا يقتل بعض أهل الكوفة في حملاته، مع تمكّنه من قتلهم، ويقتل بعضهم، فسئل× عن ذلك، فقال×: إنّ الذي لا أقتله أرى في صلبه من أهل الإيمان».
[790] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص120.
[791] اُنظر: نفس المصدر: ص120.
[792] الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص441.
[793] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص116.
[794] نفس المصدر: ص120، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص53.
[795] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص53.
[796] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص39.
[797] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص53. الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ص39.
[798] اُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ص40.
[799] إلهي قمشه أي، مهدي، كلّيات ديوان الحكيم الإلهي قمشهأي: ص227، ومعنى البيت: (يشير الشاعر أنّ وجه المعشوق يبقى رغم انكسار المرآة، وهكذا المعشوق يبقي في القلب رغم انكساره).
[800] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص124.
[801] اُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص42ـ43.
[802] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار الكبير: ص504، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص240.
[803] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص112.
[804] الفاضل الدربندي، ابن عابد، إكسير العبادات: ج3، ص72.
[805] اُنظر: الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص465.
[806] المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص283.
[807] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص176.
[808] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص58.
[809] ابن المشهدي، محمد جعفر، المزار الكبير: ص501، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص238.
[810] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص266.
[811] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص266. جاء نصّه: «عن عبد الله بن قيس، قال: كنت مع مَن غزى مع أمير المؤمنين× في صفّين، وقد أخذ أبو أيّوب الأعور السلمي الماء وحرزه عن الناس، فشكى المسلمون العطش، فأرسل فوارس على كشفه، فانحرفوا خائبين، فضاق صدره، فقال له ولده الحسين×: أمضي إليه يا أبتاه؟ فقال: امض يا ولدي، فمضى مع فوارس، فهزم أبا أيّوب عن الماء، وبنى خيمته وحطّ فوارسه، وأتى إلى أبيه وأخبره، فبكى علي×، فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين، وهذا أوّل فتح ببركة الحسين×؟ فقال: ذكرت أنّه سيُقتل عطشاناً بطفّ كربلاء، حتّى ينفر فرسه ويحمحم، ويقول: الظليمة الظليمة لأمّة قتلت ابن بنت نبيّها».
[812] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص112.
[813] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص209.
[814] نفس المصدر: ص209.
[815] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار الكبير: ص500، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص235.
[816] ابن المشهدي، محمد بن جعفر، المزار الكبير: ص505، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص240.
[817] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص131ـ132.
[818] اُنظر: المقرّم، عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص226.
[819] الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص502، ص 506.
[820] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص142ـ143.
[821] اُنظر: الحائري، محمد مهدي، معالي السبطين: ص507. جاء نصّه: «لقد مات طفلان عشيّة يوم العاشر من أهل البيت من الدهشة والوحشة والعطش، قال: فلمّا ذهبت زينب‘ في جمع العيال والأطفال، لمّا جمعتهم إذا بطفلين قد فُقدا، فذهبت في طلبهما، فرأتهما معتنقين نائمين، فلمّا حرّكتهما، فإذا هما قد ماتا عطشاً».
[822] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص142.
[823] اُنظر: الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة197، ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج2، ص201ـ202.
[824] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة 197. جاء نصّه: «ولقد قُبض رسول الله’، وإنّ رأسه لَعلى صدري، ولقد سالت نفسه في كفّي، فأمررتها على وجهي، ولقد وليت غسله’ والملائكة أعواني، فضجّت الدار والأفنية، ملأ يهبط وملأ يعرج، وما فارقت سمعي هينمة منهم. يصلّون عليه حتّى واريناه في ضريحه».
[825] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص363ـ364، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج43، ص214ـ215.
[826] اُنظر: الأربلي، علي بن عيسى، كشف الغمّة: ج1، ص583، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص137.
[827] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص18، ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص29، و44.
[828] اُنظر: الأربلي، علي بن عيسى، كشف الغمّة: ج1، ص583، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص137.
[829] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص116، ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص86، ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص25.
[830] خيمة دار الحرب هي خيمة كبيرة في مخيّم الإمام الحسين×.
[831] وقد جاء في بعض الأخبار حول رضّ الجسد: «نحن رضضنا الصدر بعد الظهر» (ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص135). وقد يقال: «أرز مرضوض، أي: الأرز الذي سقطت قشره وظهرت لبّتهن، والرضّ يعني ذهاب اللحم بسبب ضرب الحديد وخروج العظم، فيقال لذلك: عظم مرضوض، أو لحم مرضوض» (اُنظر:ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج7، ص154). جاء نصّه: «رضض: الرَّضُّ: الدَّقُّ الجَرِيشُ... رَضَّ الشيءَ يَرُضُّه رَضّاً، فهو مَرْضُوضٌ ورَضِيضٌ ورَضْرَضَه: لم يُنْعِمْ دَقَّه، وقيل: رَضَّه رَضّاً كسَره، ورُضاضُه كُسارُه. وارتَضَّ الشيءُ: تكسّر».
[832] البهبهاني، محمد باقر، الدمعة الساكبة: ج4، ص374.
[833] البحراني، عبد الله، عوالم العلوم: ج11، ص958.
[834] البقرة: آية127.
[835] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص113.
[836] محتشم الكاشاني، علي بن أحمد، ديوان مولانا محتشم الكاشاني: ص326. ومضمون البیت: (يا جدّاه، هذا حسينك صريعاً على الأرض، هذا حسينك قتيلاً مضمّخاً بالدماء).
[837] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج1، ص60، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج36، ص205.
[838] محتشم الكاشاني، علي بن أحمد، ديوان مولانا محتشم الكاشاني: ص323. ويصف الشاعر الإمام الحسين× كالسفينة التي انكسرت في طوفان كربلاء، وأصبح ميدان كربلاء مضطرباً بالغبار والدماء.
[839] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص134.
[840] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص261.
[841] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص261ـ 262. جاء نصّه: «فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقيّة جدّي وأبي وأخوتي، فقلت: وكيف لا أجزع وأهلع، وقد أري سيّدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي وأهلي مضرّجين بدمائهم، مرمّلين بالعري، مسلّبين، لا يُكفّنون ولا يوارون، ولا يعرج عليهم أحد، ولا يقربهم بشر، كأنّهم أهل بيت من الديلم والخزر، فقالت: لا يجزعنّك ما تري، فوالله إنّ ذلك لعهد من رسول الله’ إلى جدّك وأبيك وعمّك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمّة، لا تعرفهم فراعنة هذه الأمّة، وهم معروفون في أهل السماوات أنّهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة فيوارونها، وهذه الجسوم المضرّجة، وينصبون لهذا الطفّ علماً لقبر أبيك سيّد الشهداء، لا يُدرس أثره، ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيّام، وليجتهدنّ أئمّة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره إلّا ظهوراً، وأمره إلّا علوّاً».
[842] صحيفة الإمام الرضا×: ص77، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج98، ص114. وقد ورد فيهما: «عن الرضا، عن آبائه^، قال: قال علي بن الحسين÷: كأنّي بالقصور وقد شُيّدت حول قبر الحسين×، وكأنّي بالأسواق قد حفّت حول قبره، فلا تذهب الأيّام والليالي حتّى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان».
[843] اُنظر: الفاضل الدربندي، ابن عابد، إكسير العبادات: ج2، ص627ـ629.
[844] كان اسمها الأصلي أمينة، وبما أنّها كانت تتمتّع بالسكينة الإلهيّة، اشتهرت بهذا الاسم (اُنظر: أبو الفرج الإصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص94).
[845] القمّي، عباس، الكنى والألقاب: ج2، ص465. جاء نصّه: «إنّ الحسن بن الحسن بن علي خطب من عمّه الحسين× إحدى بنتيه: فاطمة أو سكينة، وقال اختر لي إحديهما، فقال الحسين×: قد اخترت لك ابنتي فاطمة، فهي أكثرهما شبهاً بأمّي فاطمة بنت رسول الله|، أمّا في الدين فتقوم الليل كلّه، وتصوم النهار، وأمّا في الجمال فتشبه الحور العين، وأمّا سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى، فلا تصلح لرجل»
[846] اُنظر: الكفعمي، إبراهيم بن علي، المصباح في الأدعية: ص741.
[847] وقد سمع جماعة صوت تلاوة القرآن الكريم يخرج من منحر الإمام الحسين×، وهذه التلاوة قد انبعثت من المنحر بلسان غيبي.
[848] الكفعمي، إبراهيم، المصباح في الأدعية: ص741.
[849] البحراني، عبد الله، عوالم العلوم: ج11، ص954، وفيات الأئمّة: ص441. وجاء في الوفيات: «وروي عن زين العابدين×، أنّه قال: رأيتها تلك الليلة تصلّي من جلوس، وروى بعض المتبّقين عن الإمام زين العابدين×، أنّه قال: إنّ عمّتي زينب كانت تؤدّي صلواتها من الفرائض والنوافل عند سير القوم بنا من الكوفة إلى الشام من قيام، وفي بعض المنازل كانت تصلّي من جلوس، فسألتها عن سبب ذلك، فقالت: أصلّي من جلوس لشدّة الجوع والضعف منذ ثلاث ليال... ».
[850] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص305.
[851] اُنظر: البحراني، عبد الله، عوالم العلوم: ج11، ص953ـ954، وفيات الأئمّة: ص440ـ 441.
[852] البحراني، عبد الله، عوالم العلوم: ج11، ص958.
[853] الكهف: آية9.
[854] لم يرد الإمام سيّد الشهداء× حال حياته، تسيير الأمور بالإعجاز، ولكن بعد الشهادة فتح ميدان الإعجاز. نعم، كان الإعجاز لجماعة خاصّة ممّن لديهم أذن سامعة وعين باصرة، ولذا لم يسمع صوت تلاوة القرآن إلّا جماعة خاصّة، وهم أهل البيت^، وقليل من غيرهم، وأمّا عامّة الناس فلم يسمعوا هذه التلاوة.
وقد وردت جملة من المعاجز بشأن قبر سيّد الشهداء×، وذلك لمّا أرسلوا الماء إلى قبره الطاهر، فاقترب الماء من القبر، ولكنّه رجع، ولمّا أرادوا حرث القبر بواسطة المحاريث الحيوانية، امتنعت تلك الحيوانات من وطأ قبره «وأُمرت بالبقر لتمخره وتحرثه، فلم تطأه البقر، وكانت إذا جاءت إلى الموضع رجعت عنه» (الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص326) ولا دليل على إنكار هذه المعجزات؛ وذلك لأنّ الأئمّة^ هم مظهر قدرة الحقّ، فتارة يسمحون للخيل أن تطأ أجسادهم، وأخرى لا يسمحون للثور أن يحرث قبورهم، فهم قد قدّموا أنفسهم ومهجهم تضحية وإيثاراً بمقدار ما وجب من الجهد والسعي، وبعد ذلك جاء دور الأجر وهو الإعجاز الإلهي.
[855] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص115.
[856] نفس المصدر: ج45، ص115.
[857] نفس المصدر: ج45، ص115.
[858] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص115.
[859] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص160. جاء نصّه: «ثمّ إنّ ابن زياد جلس في القصر للناس، وأذن إذناً عامّاً، وجيء برأس الحسين×، فوُضع بين يديه، وأدخل نساء الحسين وصبيانه إليه، فجلست زينب بنت علي÷ متنكّرة، فسأل عنها، فقيل: هذه زينب بنت علي، فأقبل عليها، فقال: الحمد لله الذي فضحكم، وأكذب أحدوثتكم، فقالت: إنّما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، وهو غيرنا، فقال ابن زياد: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فقالت: ما رأيت إلّا جميلاً، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاجّ وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمّك يا بن مرجانة».
[860] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص116. جاء نصّه: «فغضب ابن زياد واستشاط، فقال عمرو بن حريث: أيّها الأمير، إنّها امرأة، والمرأة لا تؤاخذ بشيء من منطقها، ولا تُذمّ على خطابها...فقال ابن زياد: هذه سجّاعة، ولعمري لقد كان أبوها سجّاعاً شاعراً، فقالت: ما للمرأة والسجاعة؟ إنّ لي عن السجاعة لشغلاً، ولكنّ صدري نفث بما قلت».
[861] الزمر: آية42.
[862] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص116ـ117. جاء نصّه: «وعُرض عليه علي بن الحسين÷، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا علي بن الحسين، فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فقال له علي×: قد كان لي أخ يُسمّى علياً، قتله الناس، فقال له ابن زياد: بل الله قتله، فقال علي بن الحسين×: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)، فغضب ابن زياد، وقال: وبك جرأة لجوابي، وفيك بقيّة للردّ علي؟! اذهبوا به فاضربوا عنقه. فتعلّقت به زينب عمّته، وقالت: يا بن زياد، حسبك من دمائنا، واعتنقته وقالت: والله، لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه، فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة، ثمّ قال: عجباً للرحم، والله إنّي لأظنّها ودّت أنّي قتلتها معه، دعوه فإنّي أراه لما به.
[863] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ج162، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص118. جاء نصّه: «فقال علي× لعمّته: اسكتي يا عمّة، حتّى أكلّمه، ثمّ أقبل، فقال: أبالقتل تهدّدني يا بن زياد، أما علمت أنّ القتل لنا عادة، وكرامتنا الشهادة».
[864] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص389، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج43، ص286.
[865] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص126.
[866] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص113.
[867] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص108، المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص280.
[868] نفس المصدر: ص108، نفس المصدر: ج44، ص280.
[869] يوسف: آية65.
[870] اُنظر: العيّاشي، محمد بن مسعود، تفسير العيّاشي: ج2، ص184.
[871] الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة: خطبة3، الفقرات16ـ18.
[872] المفيد، محمد بن محمد، المقنعة: ص521.
[873] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، مسار الشيعة: ص31. قال الشيخ المفيد: «ويستحبّ تناول شيء من تربة الحسين×، فإنّ فيها شفاء من كلّ داء، ويكون ما يُؤخذ منها مبلغاً يسيراً».
[874] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص24.
[875] الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص297، القمّي، عباس، مفاتيح الجنان: الزيارة الجامعة الكبيرة.
[876] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص142ـ 143.
[877] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص93، ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص2.
[878] المفيد، محمد بن محمد، الأمالي: ص338، الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص115.
[879] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص243.