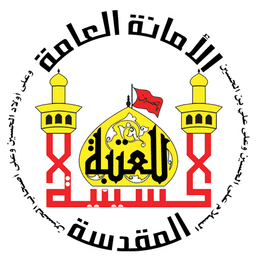_ إليكِ يا مُمتحنةُ، إليك يا صابرةُ.
_ إليكِ يا أمةَ الله وسيّدة النساء.
_ إليكِ يا بَضعةَ رسولِ الله وأُمَّ الأوصياء.
_ إليكِ أيّتُها المهضومةُ المظلومة، الممنوعة حقَّها.
_ إليكِ أيّتُها الصّديقةُ الشهيدة.
_ إليكِ أيتُها المعصومة الشّفيعة.
_ إليكِ يا روحَ رسول الله التي بين جنبيه، وريحانته من الدنُيا.
_ إليكِ يا سيّدتي يا فاطمة الزهراء، أُقدِّم هذه البضاعة المزجاة فتفضّلي عليَّ بالقبول والإحسان واشفعي لي عند ربِّك وربّي فإنّه أكرم مسؤول وأعظم مأمول.
الراجي شفاعتكم
كاظم
مقدمة المركز
العلم والقراءة والكتابة بالقلم، قواعد المجد، ومفاتيح التنزيل، وديباجة الوحي، ومشرق القرآن الكريم، بها يقوم الدين، وتُدوّن الشرائع، وتحيى الأمم، وتُبنى الحضارات، ويُكتب التاريخ، ويُرسم الحاضر والمستقبل، وبها تتمايز المجتمعات، وتختلف الثقافات، ويُوزن الإنسان، ويتفاضل الناس، ويزهو ويفتخر بعضهم على البعض الآخر.
في ضوء هذه القيم والمبادئ السامية، ومن منطلق الشعور بالمسؤولية، وبالتوكل على الله تبارك وتعالى، بذلت الأمانة العام للعتبة الحسينية المقدّسة جهوداً كبيرة واهتمامات واسعة لدعم الحركة العلمية والفكرية والثقافية، وتطوير جوانب الكتابة والتأليف والتحقيق والمطالعة، وذلك عن طريق الاهتمام بالشؤون الفكرية، وافتتاح المؤسسات ومراكز الدراسات العلمية، وبناء المكتبات التخصّصية، والتواصل مع الأساتذة والعلماء والمفكّرين، وتشجيع النّخب والكفاءات والطاقات القادرة على بناء صروح العلم والمعرفة.
ويُعد مركز الدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية في النجف الأشرف وقم المقدسة، امتداداً لتلك الجهود المباركة، وقد عمل منذ تأسيسه وبأقسامه ووحداته المتنوّعة على إثراء الواقع العلمي والفكري، وذلك من خلال تدوين البحوث، وتأليف الكتب وتحقيقها ونشرها، وإصدار المجلات المتخصّصة، والمشاركة الفاعلة مع شبكة التواصل العالمية، وإعداد الكوادر العلمية القادرة على مواصلة المسيرة.
ومن تلك الأمور المهمّة التي تصدّى مركزنا المبارك للقيام بها وتفعيلها بشكل واسع، في إطار وحدة التأليف والتحقيق، هي الاهتمام بنشر التراث العلمي والنتاج الفكري والكتابات التخصّصية للعلماء والمحقّقين والباحثين، وذلك بهدف فسح المجال وفتح الأبواب والنوافذ أمام قرّاء الفكر، وطلاب العلم والحقيقة.
ومن تلك النتاجات العلمية والقيّمة، هذا السفر الماثل بين يديك عزيزي القارئ، وهو كتاب (معين الخطباء.. محاضرات في العقيدة والأخلاق) للخطيب الألمعي فضيلة الشيخ كاظم البهادلي، والذي سلط الضوء فيه على مجموعة كبيرة من المسائل العقائدية والأخلاقية وكذا الفقهية والتاريخية من خلال مئة مجلس حسيني قيّم، والتي تعد عملاً جاهزاً لرواد المنبر الحسيني خصوصاً الخطباء الذين هم في سلم الصعود والرقي، وقد ابتدأت أكثر المجالس في هذا الكتاب بالشعر القريض، ثم اتبعه بالشعر الدارج، ثم بعد ذلك يبتدأ المجلس بآية أو رواية، ثم يتم تسليط الضوء على أحد المفاهيم الإسلامية المستوحاة من تلك الآية أو الرواية، فيتناولها من جوانب عديدة، بأسلوب واضح وفق منهجة علمية خطابية، داعماً ذلك بالقصة والشواهد التاريخية، ثم يتطرق إلى المصيبة والأبيات الشعرية المناسبة لها.
ويعتبر هذا العمل من الأعمال المهمة في الأوساط العلمية والثقافية وذلك بتبع ما للمنبر الشريف من أهمية قصوى في هذا الميدان، إذ أن للمنبر الدور الأكبر في صياغة الثقافة العامة عند المجتمع، وهذا العمل يعتبر رافداً صافياً ومعيناً أميناً لخطباء المنبر الحسيني أيدهم الله تعالى وسدد خطاهم.
وفي الختام نتمنى للمؤلف دوام التوفيق في خدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنه سميع مجيب.
اللجنة العلمية
في مركز الدراسات التخصصية
في الضة الحسينية
الحمدُ لله الذي تفرّد بالوحدانية، وارتفع عن وصف المخلوقين له بالإنيّة، وحارت العقول عن كُنه معرفته، وتلكّأت الألسن عن إدراك صِفته، الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك.
والصَّلاة والسَّلام على خير الأنام، خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمِين وعلى أهل بيته الطّيبين الطّاهرين، لا سيّما بقيّة الله في الأرضين، مولاي وولي نعمتي، صاحب العصر والزمان الحجّة بن الحسن#، واللعن الدائم المؤبّد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
أمّا بعد، فلا يخفى على ذي لُبٍّ ما للخطابة من أهميّة في هداية الناس وتثبيت ما اهتدوا إليه، ولا يشكّ ذو مسكةٍ بأنّها من وظائف الأنبياء والمرسلين والأوصياء والصّالحين، وأنّ ثوابها جسيم ومقامَها عظيم.
فعن رسول الله’ أنّه قال لأمير المؤمنين×: «لئن يهدي الله بك رجُلاً خيرٌ لك من أن يكون لك حُمر النعم»[1].
فهداية إنسان واحد خيرٌ من أفضل النعم وأنفَسَها! فكيف إذا كانت الهداية لمئات البشر ولمرّ العصور!!
والهداية هذه تارة تكون بالفعل وأُخرى بالقول، وكلّما كان القول تابعاً لإخلاص القائل وصدق نيّته وعمله كان التأثير أكبر والنفع أوسع، وقد قيل في القِدَم: «ما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان، وما خرج من القلب دخل في القلب».
فينبغي لنا ـ معاشر الخطباء ـ الالتفات إلى ذلك جيّداً؛ لأنَّ التوفيق كلّ التوفيق في الإخلاص ومتابعة القول للعمل، فالخلاص في الإخلاص.
ومن جهة أُخرى، ينبغي لسائر المؤمنين أيضاً أن ينظروا للخطيب بعين الإنصاف، وأن لا يتّبعوا عثراته وزلاته وسقطاته، فنحن معاشر البشر عُرضةً للخطأ والنسيان إلّا من خصّه الله وحباه؛ ومن هنا جاء النهي والتحذير عن تتبُّع العثرات على لسان النبيِّ الأكرم’ حيث قال: «لا تطلبوا عثرات المؤمنين؛ فإنّ مَن تتبَّع عثرات أخيه تتبَّع الله عثراته، ومَن تتبَّع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته»[2].
والخطيب الجيد هو مَن يبذل قُصارى جهده في إنجاح منبره، فإن وُفّق فبها ونعمت، وإن أخفق فنعين بعضُنا البعضَ لتسديده وبيان ما يمكن له أن يتلافى به ما أخفق بسببه، فمنه ومنّا السعي ومن الله التوفيق، قال الشاعر:
على المرء أن يسعى بمقدارجُهده وليس عليهِ أن يكونَ موفقا
وفي هذا السياق جاءت هذه المحاولة المتواضعة في هذا الكتاب ـ مُعين الخطباء ـ لتعين مَن يحتاج الإعانة، وتكون تذكرةً لمَن لم تُسعفه الذاكرة، ونافلةً لأساتذة الفنّ وكبار الخطباء، وهي عبارة عن مجموعة محاضرات ومجالس عزائية ألقيتُ أكثرَها ـ إذا لم أقل: كُلَّها ـ وقد نالت إعجاب ثُلّةٍ من إخواني الخطباء، فالتمسني بعض إخوتي من الخطباء الفضلاء نشْرَها؛ لتعمَّ الفائدة، فنزلتُ عند رغبتهم، شاكراً لهم حُسن ظنّهم بي وبها، وهي نافعة إن شاء الله تعالى لمَن نظر فيها نظرةً فاحصةً، ومن محاسنها أنّها اشتملت على المصادر التي استقيت منها المادّة، وقد أرجعت ما فيها إلى مصدره ومرجعه، وهي مائة مجلس ومحاضرة، اشتمل الجزء الأول على أربعين منها؛ تيمّناً بهذا العدد المبارك، وثلاثين في الجزء الثاني، وثلاثين في الجزء الثالث أيضاً، واشتمل الكتاب ـ بأجزائه الثلاثة ـ على مجالس شهر محرّم الحرام وبعض مناسبات شهر صفر والأيام الفاطميّة وشهر رمضان المبارك ، وغير ذلك من مجالس ومحاضرات متفرِّقة، والطابع الغالب على الجميع هو العقائدي والأخلاقي.
وسمّيتُه (مُعين الخطباء) اسماً على مُسمّاه إن شاء الله تعالى؛ ليعينني وإخوتي أولاً، ولأجل أن يشملنا قول الرسول الأكرم’: «مَن حفظَ من أُمّتي أربعين حديثاً ممّا يحتاجون إليه من أمر دينهم بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً»[3].
فقُلت ـ في نفسي ـ: وأربعين مجلساً إنشاء الله، خصوصاً مع الالتفات إلى قوله’: «ممّا يحتاجون إليه» أو الالتفات إلى الحديث الآخر المُشتمل على سؤال الإمام أمير المؤمنين× لرسول الله’: «يا رسول الله، أخبرني ما هذه الأحاديث؟».
فقال’: «أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، وتعبُده ولا تعبد غيره، وتُقيم الصلاة بوضوءٍ سابغٍ في مواقيتها ولا تؤخّرها فإنَّ في تأخيرها من غير علّة غضب الله}، وتؤدّي الزّكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحجّ البيت إذا كان لك مالٌ وكنت مستطيعاً، وأن لا تعقّ والديك، ولا تأكل مال اليتيم ظُلماً، ولا تأكل الربا، ولا تشرب الخمر... وأن تصبر على البلاء والمُصيبة، وأن تشكر نعم الله التي أنعم بها عليك... وأن تتوب إلى الله} من ذنوبك فإنّ التائب من ذنوبه كمَن لا ذنب له... وأن تُكثر من قراءة القرآن وتعمل فيه... فهذه أربعون حديثاً مَن استقام عليها وحفظها عنّي من أُمّتي دخل الجنّة برحمة الله، وكان من أفضل النّاس وأحبِّهم إلى الله} بعد النبيّين والصدّيقين والشُهداء والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقاً»[4].
ومحاضراتنا ومجالسنا المائة المبثوثة في هذا الجزء وبقية المحاضرات والمجالس في الجزءين الآخرين لا تعدو هذا المعنى، وكرم الله أكبر من أن نصِفَه أو نتصوّره، فنسأله تبارك وتعالى أن يشملنا بعفوه وكرمه.
وفي الختام أتقدّم بجزيل شكري وامتناني للإخوة الأساتذة والخطباء، الذين وازروني في هذا العمل، وأخصّ بالذكر منهم: سماحة السيد علي الموسوي، والشيخ محمّد صالح الحلفي، والشيخ سعد الغري، والشيخ محمّد الساعدي، سائلاً المولى عزّ وجلّ لهم جميعاً دوام التوفيق، كما أقدّم شكري للأخوة العاملين في مركز الدراسات التخصصية في النهضة الحسينية الذين أخذوا على عاتقهم مراجعة الكتاب ونشره، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبّل منّا جميعاً هذه المحاضرات بأحسن القبول، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا، وذخراً لنا يوم نلقاه، يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا مَن أتى الله بقلبٍ سليم، وأن تكون من العلم الذي يُنتفع به بعد حياتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا.
(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ).
كاظم البهادلي
قم المقدّسة/ أيام شهادة السيدة الزهراء‘
1434ﻫ
المحاضرة الأُولى: تعظيم الشعائر
|
أطلَّ علينا بالخُطوبِ مُحرّمُ |
***
(فائزي)
هلّت الشّيعة بالحزن يهلال عاشور
او نصبت مياتم للعزيّة وتلطم اصدور
اهلال المحرّم ليش أشوفك كاسف اللون
لابس سوادك ليش گلي اشصار بالكون
ونّ الهلال اوگال سيد الرُسل محزون
او كلّ العوالم محزنة والدين مقهور
من حين هلّ الشهر هلّ ابكل الأحزان
اوجدد مُصاب اللّي گظه بالطفّ حيران
ناحت عليه املاكها والأنس والجان
على قتيل اللي گظه بالطفّ منحور
وأعظم مصيبة ذوّبت مُهجة اُّفّادي
أهل المدينة سمعوا الزهره تنادي
عاشور جاني اوزاد حزني على أولادي
نصبت مياتم يا خلگ في وسط الاگبور
صاحت أو منها الدمع فوگ الخد مسجوم
ما ظنّتي من هلسفر يرجع المظلوم
هلّ المحرم وامتلأ گلبي بالهموم
من حين شفت الشهر صار الگلب مكسور
(مجاريد)
|
نارك ابگلبي دوم تـسري واعليك أونّ وآنه ابگبري |
(أبوذية)
|
اهلال الكدر والأحزان هلّيت |
***
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾[6].
الشعائر واحدها الشعيرة، والشعيرة: هي كلّ ما له دخل في إحياء معالم الدين الّتي ندب الله إليها عبادَه[7]. وهي لغةً: العلامة.
ولقد تناول القرآن الكريم موضوع الشعائر بصريح اللفظ في آيات أربع:
الآية الأُولى: في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾[8].
والآية الثانية: في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ ﴾[9].
والآية الثالثة: في سورة الحجّ، وهي قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾[10].
والآية الرابعة: في سورة الحجّ أيضاً، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ ﴾[11].
والآية محل البحث ندبت إلى تعظيم الشعائر التي لها صلة بالله تبارك وتعالى، ولها دخل في إحياء معالم الدين على ما جاء في بعض كلمات أهل اللغة في بيان الاصطلاح منهما.
والآية فيها دلالة واضحة على محبوبية التعظيم لشعائر الله، حيث عدّها الباري من تقوى القلوب.
وقد فسّر بعض علماء العامّة الآية المباركة بأنّ المقصود من الشعائر فيها: جميع ما أمر الله به وعفا عنه، أي جميع فرائضه.
وحُكي عن القرطبي في أحكام القرآن: أنّ المقصود من الشعائر هي جميع العبادات.. الّتي أشعرها الله، أي جعلها أعلاماً للناس.
والخلاصة: أنّ المراد من الشعيرة والشعائر نشر الدين، وبث نور الله سبحانه وتعالى وعدم إطفائه، ورفعة الدين، وطلب سموّه وعلوّه[12].
والآية محل البحث فيها ثلاثة محاور:
المحور الأوّل: هو طلب التعظيم.
المحور الثاني: موضوع التعظيم هو شعائر الله.
المحور الثالث: نتيجة التعظيم وهي التقوى الناشئة من صفاء القلب، والنابعة عن الإحساس بإدراك الواجب المطلوب امتثاله في المحور الأوّل.
فبمقتضى المحور الأوّل يكون كلّ إنسان مسؤولاً عن إفشاء طلب الباري، أو قل: ندب الباري وترغيبه في إقامة وامتثال ما أحبّه، فيكون حال هذا الامتثال حال امتثال بقية الأوامر الإلهية، كالصوم والصلاة وما شابه ذلك، فكما أنّ الإنسان يؤجر ويُثاب على امتثال صيام شهر رمضان، ويُعاقب بأشدّ العقوبات وأصرمها في حالة المخالفة، كذلك الحال في إقامة وتعظيم هذه الشعائر عند ملاحظة أنّ الطلبَ والترغيب تعلّق في تعظيمها أو عدم خذلانها، في الآيات الباقية المتناولة لنفس الموضوع، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾[13] الناهية عن هتك وخرم شعائر الله تبارك وتعالى.
والآيات وإن كان بعضها وارداً في سياق آيات الحجّ إلّا أنَّ هذا لا يمنع من التعميم، كما هو مقتضى الحال في بقية آيات القرآن الكريم بالنسبة إلى الموضوعات الأُخرى؛ لأنَّ القرآن يجري مجرى الليل والنهار والشمس والقمر، كما ورد في ألسنة الروايات[14].
بعد ملاحظة أنَّ الشعائر وإقامتها ليست أمراًَ توقيفيّاً، بل تركه الشارع بيد العُرف ما لم يرد نهي عن مسير العرف الّذي يريده الشارع الأقدس[15].
ولأجل ذلك توسّع العُلماء (قدس الله أسرارهم) في إطلاق لفظة الشعائر.
قال المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: «نُقل أنّ تجديد قبور الأئمّة^ مستثنى من كراهة تجديد القبر بعد الاندراس؛ لأنَّ تجديد قبور الأئمّة^ فيه تعظيم لشعائر الله، وبقاء الرسم لتحصيل الزيادة الموجبة للثواب العظيم»[16].
بل إنَّ بعض الفقهاء أوجب الهجرة على مَن يضعف عن إظهار شعائر الإسلام[17]، من دون تحديدها بمصداق أبداً، وإنّما ترك ذلك للعرف. فيمكن أن يكون الضعف في إظهار الشعائر متمثلاً بمنع الحاكم الجائر عن إقامة صلاة الجمعة والجماعة، أو يكون عن طريق منع المؤمنين من أداء زكاتهم، إلى غير ذلك من الأمثلة.
إقامة المراسم الخاصّة عند الشيعة:
البحث هنا في ماهيّة المراسم التي يقيمها الشّيعة على أئمتهم، خصوصاً على أبي عبد الله الحسين×، فهل هي داخلة في جملة الشعائر التي أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمها وحُرمة هتكها وخذلانها أم لا؟
والجواب واضح بعد ما قدّمنا من التعريف اللغوي والتفسير القرآني للشعائر عند المسلمين، وأنَّ المقصود بها كلّ معالم الدين الّتي ندب الله إليها عبادَه، والتي يجب على المسلم مهاجرة وطنه وبلاده فيما لو ضعفتْ فيها إلى بلاد يتمكّن من إقامتها وإظهارها فيها.
فبعد معرفة أنّ تجديد قُبور الأئمّة^ هو من شعائر الله التي ندب إليها ـ كما تقدّم ـ فلا إشكال في أنّ إحياء ذكرى أئمة أهل البيت^ أولى وأجلى.
فإنّ البكاء ولبس السواد والرثاء وإقامة المآتم على الأئمّة^ من أجلى وأوضح الشعائر الإلهية؛ لأنّ تعظيمهم تعظيم لرسولِ الله’.
وبما أنَّ الكلام في الليلة الأُولى من محرّم الحرام فلنعطف البحث على خصوص قضيَّة الإمام الحسين×.
إقامة مراسم العزاء على سيد الشهداء× من شعائر الله:
ثمّ إنّه بعد التسالم على دخول إقامة المراسم على الأئمّة^ في الشعائر الإسلامية، وأنّه من صُغريات كبرى شعائر الله، نعطف البحث على خصوص شعائر الإمام الحسين×، فإنّه من الموضوعات الّتي أُثير حولَها التّشكيك من هنا وهناك، حتّى أصبح البعضُ ـ وللأسف الشديد ـ يسخر من الشّيعة بكلمات نابية وساخرة ومستصغرة لمقامهم، مع ارتكاب هؤلاء المُهرّجين لأكبر الكبائر من دون حياءٍ ولا ورع.
وبكلمة مختصرة نُجيب هؤلاء ضُعّاف النفوس بما حدَّثَ بهِ رسولُ الله| حبيبَه أميرَ المؤمنين×، حيث قال له: «وإنَّ حُثالةً مِنَ النّاسِ يُعيّرونَ زُوّار قبورِكم كما تُعَيّرُ الزانيةُ بزناها، اُولئك شرارُ أُمّتي لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة»[18].
ولكن ما ضرّ الّذين يقيمون شعائر دينهم أن يسخر منهم الجاهلون ما داموا يعلمون أنّهم على حقٍّ، وأنَّ أعداءهم على باطلٍ، ولقد شكوا عند الإمام الصّادق× استهزاء الأعداء بهم، فقال× مهدّئاً روعَهم: «والله لحظهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمّدٍ تباعدوا»[19].
وقال له ذريح المحاربي: إنّي إذا ذَكرتُ فضل زيارة أبي عبد الله× هزأ بي وُلْدي وأقاربي. فقال×: «يا ذَريح، دَع النّاسَ يذهبونَ حيثُ شاءوا»[20].
وما قيمة الاستهزاء حتّى يميل الإنسان عن خطّه الصائب بسببه؟ وما قيمة المستهزئين أنفسهم حتّى يعير لهم الإنسانُ اهتماماً؟
ولو كانت لهم قيمة لعملوا ما ينفعهم وينفع الناس، ولكن حيث لا قيمة لهم ولا هدف، تواضعوا بأنفسهم، فرضوا أن يكونوا مستهزئين، فحسبهم هذا الاعتراف العملي بفشلهم، وبطلان اتّجاههم[21].
مع أنّه يكفي في المقام عدم وجود دليل مانع من إقامة مراسم عزاء سَيّد الشُهداء×، بل وعزاء سائر الأئمّة^، فالأصل في مثل هكذا موارد هو الإباحة، مضافاً لما ورد عنهم وعن جدِّهم الأكرم’ من الحثّ الأكيد على إقامة العزاء، ويكفيك ما كان يصنعه النبيّ وأهلُ بيتهِ^ في أيّام المُحرّم، حتّى رُويَ أنَّ الإمام الكاظم× لم يُرَ ضاحكاً في تلك الأيّام[22].
وروي عن أبي جعفر الباقر× أنّه قال: «نظر النبيُّ’ إلى الحسين× وهو مقبل، فأجلسه في حجره، وقال: إنَّ لقتل الحسين× حرارةً في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً. ثمّ قال أبو جعفر: بأبي قتيل كُلِّ عبرةٍ. قيل: وما قتيل كلّ عبرة؟ قال: لا يذكره مؤمن إلّا بكى»[23].
وفي كامل الزيارات عن أبي حمزة، عن أبيه، عن الإمام الصّادق× أنّه قال: «إنَّ البكاء والجزع مكروه للعبد في كُلِّ ما جزع، ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي، فإنّه مأجور»[24].
وعن الإمام الرضا× أنّه قال: «مَن تذكّر مُصَابَنا وبكى لما ارتُكب فينا، كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومَن ذُكِّر بمُصابِنَا فبكى وأبكى لم تبكِ عينُه يومَ تبكي العيون، ومَن جلس مجلساً يُحيي فيه أمرنا لم يمت قلبُه يوم تموت القلوب»[25].
وللبكاء على أهل البيت^ جميعاً، وعلى الحسين× بصورة خاصّة جوانب دنيوية، قد يكون أبرزها الجانب التربوي؛ لأنَّ البكاء على أيِّ شيءٍ لا يكون إلّا بعد انفعال الباكي بالحادث الأليم الّذي اكتنف ذلك الشيء، ولكلِّ حادث مجرمٌ وضحيّة، ومن الطبيعي أن يؤدّي الانفعال إلى تمييز الباكي للضحيّة ومعاداة المجرم، فتهيج فيه الثورة على الظالم والإشفاق على المظلوم، وحيث إنَّ الإمام الحسين× ويزيد لم يكونا بطلين وقفا على طرفي نقيض فاشتبكت مصالحهما، وتصارعا على حكم مثل كرةِ الطّراد، وإنّما كان كُلُّ واحدٍ منهما يمثّل جبهةً بلغ فيها الذروة، فتوفّر في معركتهما من المعاني الحيويّة ما لم تتوفر في أيّةِ معركةٍ أُخرى، كان البكاء على الإمام الحسين× يعني توجيه الباكي نحو جميع الفضائل وإثارته ضدّ جميع الرذائل، ومثل هذه الفائدة السخيّة لا يمكن أن تحصل من البكاء على أيِّ شهيدٍ آخر، ولا من أيِّ شيءٍ آخر، سوى البكاء على الإمام الشهيد، كان حريّاً بتأكيدات الأئمّة الأطهار^، والمكافأة بذلك الثواب العظيم(الجنّة)؛ لأنّه يدفع إلى انتزاع صفات أهل النار وتقمّص صفات أهل الجنّة، ولو بعد حينٍ، حين يُتاح للبكاء أن يتفاعل مع الباطن ويخلق فيه أثره التربوي.
وهكذا لا تبدوا الأحاديث السّابقة مبالغة في تكثير ثواب البكاء على الإمام الشّهيد، ولا تكشف عن مجازفة في جعل الثواب إزاء البكاء عليه، وإنّما تُعبّر عن ثواب البكاء بمقتضى أثر البكاء[26].
وهكذا داوم الشّيعة في كُلِّ زمانٍ ومكانٍ على إقامة الشعائر الحسينيّة، يُنقلُ أنَّ شاباً مُوالياً لأهل البيت^ من أهل البحرين، كان مُقيماً في بريطانيا لأجل الدراسة، اطّلع في يوم من الأيّام على كتاب في مذكّرات لأحدِ الضُبّاط البريطانيين كان لها الأثر الكبير في حياته. والحادثة هي أنّ هذا الضابط حصلت له علاقة مع عائلةٍ عراقيةٍ في بغداد من المتديّنين، وكان يزورهم بين آونةٍ وأُخرى، وهم في المقابل يُحسنون إليه ويضيّفونه في بيتهم، فلمّا انقضت مدّتُه ورجع إلى بريطانيا طلب منهم أن يزوروه هناك، وبالفعل ما مرّت الأيّام حتّى سافروا إلى بريطانيا، وبعد وصولهم توجّهوا إلى دار الضابط، وكانت واسعةً، واقعة في إحدى ضواحي العاصمة، فأفرد لهم بيتاً مستقلاً كان موصولاً بداره، وعيّن لهم خادماً يخدمهم، وكانوا لا يغيبون عن نظره وتفقُّده، وفي صباح أحد الأيام استيقظت الزوجة وقالت لزوجها: يا أبا فلان، أشعر بضيقٍ واحتباسِ صدرٍ وهمٍّ، لا أعلمُ لماذا؟ فقال الزوج: وأنا كذلك أشعر بهمٍّ وحُزن!!
فقالت: لعلَّ أحد الأولاد أصابه مكروه، أو أحد الأقارب، أو أحد الأصدقاء. فبينما هم في هذا وأمثاله، إذ صرخت المرأة قائلةً: أبا فلان، عرفت السّبب!! فقال لها الرجل: وما هو بالله عليك؟ فقالت ـ وقد ترقرقت دموعُهاـ: دخل علينا شهر محرّم كما أعتقد. فقام الرجل مسرعاً ونظر في تقويم الأيّام، فعرف أنّ ما تقوله زوجتُه صحيح، وأنّهم في بداية شهر مُحرّم الحرام. فقالت: أسفي على وصول هذا الشهر ونحن في هذا المكان البعيد، حيث لا نسمع قراءةً ولا نستطيع الذهاب إلى المآتم، وبدأت بالبكاء والنحيب، فقال لها الرّجُل: لا عليك أنا أقرأ لك شيئاً، ولبس الرجل زيّه العربي وجلس على مرتفع، وبدأ يقرأ ويندب الإمام الغريب أبا عبد الله الحسين× ويبكي والمرأة تسمع وتبكي وتندب وتُعزّي فاطمة الزهراء‘ حتّى انتهى المجلس، فجلسا على الأرض فرحَينِ؛ حيث أدّيا حقّ ذلك اليوم من الأيّام العشرة الأُولى من المحرّم، فما مضت مدّة حتى طُرِقَ الباب وإذا بصديقهم يقول لهم: لماذا لم تخبروني بقدوم الضيوف إليكم حتى أقوم بالواجب؟! فقال له الرجل: مَن يعرفنا هنا حتى يأتي لزيارتنا؟ فقال له: أنا رأيتُ بعيني النّاسَ يدخلون هذا المكان، وهم يلبسون الملابس العربية، ورأيتُ معهم امرأة محتشمة. فبكى الرَّجُل حتى سالت دموعه كُلَّ مسيلٍ، وأخبره أنّهم أقاموا مجلس عزاء الإمام الحسين× كما كانوا يفعلون ذلك في العراق، وأنَّ أمثال هذه المجالس يرعاها أهل البيت ^، في حياتهم وبعد مماتهم.
ورحم الله الأصفهاني، حيث يقول في الاُرجوزة نادباً صاحب العصر والزمان× في مثل هذه الأيام:
|
يا غائباً مثالُه عيانُه |
ولا شكَّ أنَّ روحَ فاطمة الزهراء‘ ترفرف في هكذا مجالس، فهي بنظر الرسولِ وأهل بيته الأطهار^؛ ولذا نقرأ عزائنا لأُمِّ الذبيح، لأُمِّ المظلوم، نقرأه لأُمِّ الأئمّة فاطمة الزهراء‘:
كلّ الأهلّة تهل علينه بفرح وسرور
ودون الأهلة بحزن هلّ هلال عاشور
عاشور هلّ وصارت الضجّة بالأكوان
وناحت جميع الأنبياء والإنس والجان
والمصطفى لأجل الذبيح احسين حزنان
من لاح بآفاق السمه هلالك يعاشور
صارت جميع الناس في ضجّة وحيرة
گالوا انذبح في كربلا شيخ العشيرة
واخته إلى ابن زياد ودّوها أسيره
وسفه على زينب يا ويلي تركب الكور
(أبو ذية)
|
يا ناعي لو شفت شيعة وساده |
***
|
يا ناعياً إن جئت طيبةَ مُقبلاً |
|
|
وقد ماتَ عطشاناً بشطِّ فراتِ |
|
المحاضرة الثانية: البكاء على الحسين ×
خُذ بالبُكاءِ فقدْ أتاكَ مُحرَّمُ |
عزاؤنا لإمامنا المهدي# في هذه الليلة وللموالين:
|
گلبك هالمسيه شلون يابن العسكري حاله |
|
لو صبرك على المسكون هدّه وزلزل أجباله |
إنّا لله وإنّا إليه راجعون
***
عن سيّدنا ومولانا الإمام زين العابدين عليِّ بن الحسين السّجاد×، قال: «أيُّما مؤمنٍ دَمِعت عيناه لقتل الحُسين بن علي‘ دمعةً حتّى تسيلَ على خدّهِ بوّأه الله بها في الجنة غُرَفاً يسكنُها أحقاباً»[29].
العجبُ كُلّ العجب ممّن يزعم أنَّ المعصوم× لا يبكي، أو أنَّ البكاء لا يليق به وليس من شأنه، فإذا خطر مثل هذا في البال فهو وهمٌ صِرف؛ إذ إنَّ البكاء والرقّة من صفات المعصوم، كما أنّ الرحمة والرقّة مودعة في قلب كُلّ نبيٍ وكلّ معصوم، بل وكلّ مؤمنٍ، فضلاً عن خاتم الأنبياء’، وقد دلّت الأخبار على أنّه’ بكى في مواطن كثيرة:
منها: يوم أُحد، وذلك عندما رأى عمَّه حمزة قتيلاً، ورأى ما مُثّل به شهق.
قال ابنُ أبي الحديد: إنَّ النبي’ كان يومئذٍ إذا بكت عمّتُه صفية يبكي، وإذا نشجت ينشج، وكذلك لمّا رأى ابنته فاطمة تبكي على عمّها بكى[30]. وروي أيضاً: أنّ النبي’ لمّا رجع من أُحد فجعلت نساء الأنصار يبكين على مَن قُتل من أزواجهن، فقال’: «ولكن [عمّي] حمزة لا بواكي له»، ثُمَّ نام وانتبه وهُنَّ يبكين، قال: «فهُنّ اليوم إذا بكين يندبن حمزة»[31].
ومنها: بكاؤه على جعفر بن أبي طالب× يوم مُؤتة لمّا قُتل[32].
ومنها: لمّا أُصيبَ زيدُ بن حارثة انطلق النبيُّ’ إلى منزله، فلمّا رأته ابنةُ زيدٍ أجهشت بالبكاء، فسالت دمعتُه[33].
ومنها: بكاؤه عند موت ولده إبراهيم، فقيل له: أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال’: «إنّما أنا بشرٌ مثلكم، تدمع العين ويحزن القلب، ولا أقولُ ما يُغضب الربّ، وإنّا بفراقك يا إبراهيمُ، لمحزونون»[34].
ومن أهمّ هذه المواطن بكاؤه على الإمام الحسين×، فقد بكى على الإمام الحسين× عدّةَ مرات:
منها: قبل ولادته، وذلك لمّا هبط عليه جبرائيلُ× قال: يا مُحمّدُ، يُولد لك ولد تقتله شِرارُ أُمِّتكَ، فبكى، وقال: «لا حاجة لي فيه»، فقال جبرائيلُ: يا رسولَ الله، إنَّ الإمامة تكون فيه وفي ولده، فسكت’[35].
ومنها: بكاؤه عند ولادته، وذلك لمّا جاءت بهِ صفية بنت عبد المطلب تحمله، أخذه وشمّه ثمّ بكى، فقالت له صفية: يا رسول الله، وما هذا البكاء؟! فقال لها’: «إنّ ولدي هذا تقتله شرارُ أُمّتي، لا تخبري ابنتي فاطمة فإنّها جديدة عهد بولادتِه»[36].
ومنها: بكاؤه’ لمّا دخل على فاطمة ورأى الحسين× يبكي في المهد، فقال’: «بُنيّة سكّتيه، فإنّ بكاءَه يؤذيني»، ثُمَّ بكاه، وكان’ كُلّما نظر إليه يبكي، وإذا رآه في يوم عِيد يبكي، وإذا رآه يلعب يبكي، وكان’ يقول: «طمئنينتي حسين، روحي الّتي بين جنبي، حُسينٌ منّي وأنا من حسين، أحبَّ الله مَن أحبَّ حُسيناً»[37].
وروي أنَّه دخل الحسن وأخوه الحسين على النبيّ’ يوماً فشمَّ الحَسن× في فمه وشمّ الحُسينَ× في نحره، فقام الحسين× وأقبل إلى أُمّه، فقال لها: «أمّاه شُمِي فمِي هل تجدين فيه رائحة يكرهها جدّي رسول الله’؟» فشمّته في فمه، فإذا هو أطيب من المسك، ثمَّ جاءت به إلى أبيها، فقالت: «أبه، لِمَ كسرتَ قلبَ ولدي الحُسين×؟».
فقال’: «ممّ؟» يعني كيف إنّي كسرتُ قلب الحسين×؟، قالت: «تشمّ أخاه في فمه، وتشمّه في نحره؟!» فلمّا سمع قولَها’ بكى، وقال: «بُنية، أمّا ولدي الحسن فإنّي شممتُه في فمه؛ لأنّه يُسقى السُمّ فيموتُ مسموماً، وأمّا الحسين× فإنّي شممتُه في نحره؛ لأنّه يذبح من الوريد إلى الوريد»، فلمّا سمعت فاطمة بكت بكاءً شديداً، وقالت: «أبه، متى يكون ذلك؟» فقال: «بُنيّة في زمانٍ خالٍ مِنّي ومنك ومن أبيه وأخيه»، فاشتدّ بكاؤها، ثُمَّ قالت: «أبه، فمَن يبكي عليه ومَن يلتزم بإقامة العزاء عليه؟» فقال لها: «بُنيّة فاطمة، إنَّ نساء أُمّتي يبكون على نساء أهلِ بيتي، ورجالُهم يبكون على ولدي الحسين× وأهل بيته، ويُجددّون عليه العزاء جيلاً بعد جيل، فإذا كان يومُ القيامة أنت تشفعين للنساء وأنا أشفع للرجال، وكلّ مَن يبكي على ولدك الحسين× أخذنا بيده وأدخلناه الجنة»[38].
وقال’: «ألا وصلّى الله على الباكين على الحسين بن علي÷»[39].
فرسول الله’ تراه تارةً يدعو للباكي على الحسين×، وأُخرى يُخبرُ بفضل الباكي عليه وما له يومَ القيامة من الأجر؛ لقوله’: «كُلّ عينٍ باكية يومَ القيامة إلّا عينٌ بكت على ولدي الحسين، فإنّها ضاحكةٌ مستبشرةٌ بنعيم الجنّة»[40]، وروى العلّامة المجلسي& قال: حكى السّيد علي الحسيني قال: كُنتُ مُجاوراً في مشهد عليِّ بن موسى الرضا مع جماعة من المؤمنين، فلمّا كان اليوم العاشر من المحرَّم عقدنا مأتماً للحسين×، فابتدء رجلٌ مِنّا يقرأ مقتل الحسين×، فقرأ روايةً عن الإمام الباقر×، أنَّه قال: «مَن ذرفَت عيناه بالدّموعِ على مُصاب الحسين ولو كان مثل جناح البعوضة غفر الله ذنُوبه ولو كانت مثل زبد البحر»[41]، وكان في المجلس معنا رجل يدَّعي العِلمَ ولا يعرفه، فقال: ليس هذا صحيحاً وإنّ العقل لا يقبله. قال: وكثر البحث بيننا، ثمَّ افترقنا وهُو مُصِّرٌ على ما هو عليه، فلمّا نام تلك الليلة رأى في منامه كأنَّ القِيامة قد قامتْ وحُشِر الناس في صعيدٍ واحدٍ، وقد نُصبت الموازين، وامتدَّ الصراط ووضع للحِساب، ونُشرت الكُتب، وأُسعرتِ النيران، وزُخرفت الجنان، واشتدَّ الحرّ عليه وعطش عطشاً شديداً، فجعل يطلب الماء فلا يجده، فالتفت هناك وإذا بحوضٍ عظيم الطول والعرض، فقال في نفسِه: هذا الكوثر، فأقبل إليه وإذا عليه رجلان وامرأة، أنوارهُم مشرقة، لابسين السواد، قال: فسألتُ عنهم، فقيل لي: هذا رسولُ الله’، وهذا عليُّ×، وهذه فاطمة‘، فقلتُ: إذاً لِماذا لابسين السواد؟
فقيل لي أليسَ هذا اليوم يوم قُتل فيه الحُسين×؟!
قال: فدنوتُ إليهم، وقُلتُ لِفاطمة: سيدّتي إنّي لعطشان، فنظرت إليَّ شزراً[42] وقالت لي: أنت الذي تُنكر فضلَ البكاء على الحسين، والله لن تذوق مِنه قطرة واحدة حتى تتوبَ ممّا أنت عليه. يُقال: فانتبه من نومِه فزعاً مرعوباً، وجاء إلى أصحابه وقصَّ عليهم رؤياه، وقال: والله يا أصحابي، أنا ندمتُ ممّا صدر منّي، وأنا تائبٌ عمّا كنتُ عليه[43].
أقول: إخواني المؤمنين الحذَر الحذَر من أن يكون الإنسان يتعرّض لرفض الروايات التي لا تُناسب ذوقَه، فاُنظر إلى موقف الزهراء‘ مع هذا المُدّعي للعِلم كيف كان؟!
فإنّ إقامة العزاء والمآتم والبكاء على أبي عبد الله الحسين× ممّا هو مندوبٌ إليه في الشريعة الإسلامية، وقد ذكرتُ جُملةً من المواطن التي بكى فيها رسول الله’ على الحُسين×، وفي هذه الليلة ليلة الأوّل من شهرِ مُحرَّم الحرام هي ليلة تجدد الحُزن والبكاء على سيد الشهداء عند الأئمّة^. وهناك مواقف في غاية الحُزن لأهل البيت^ عندما كان يحلُّ شهر مُحرم الحرام.
روي عن الإمام الرضا× أنّه قال: «كان أبي إذا دخل شهر المحرّم لا يُرى ضاحكاً، وكانت الكآبةُ تغلبُ عليه حتى تمضي عشرة أيامٍ منه، فإذا كان اليوم العاشر كان ذلك اليوم يومَ مصيبته وبكائه، ويقول: هو اليوم الذي قُتل فيه الحسين»[44]، وكان× يطلُبُ من الشعراء أن يرثوا الحسين× بما جادت قرائحهم، وكان يأمرهم أن ينشدوا بصوتٍ حزينٍ، فإذا حضر الراثي ضربَ لعِياله سِتراً وأجلسهم خلفه[45]، وكان الإمام الصادق× يُشجِّع الشُعراء على نظمِ الشعر في الحسين× بأقواله الكثيرة، كقوله×: «ما من أحدٍ قال في الحسين شِعراً فبكى وأبكى به إلّا أوجب الله له الجنّة، وغفر له»[46].
دخل عليه ذاتُ يومٍ السيد الحميري&[47]، فقال له الإمام: أنشدني في الحسين شعراً. وقام الإمام وضرب سِتراً لنسائه وأطفاله، وأجلسهم خلفَ السِترِ، وجَلَس هو وأصحابُه حزيناً باكياً على مصيبة جدِّه الحسين×.
يقول السيد الحميري فأنشأتُ:
|
اُمرُر على جدث الحُسين |
يقول الحميري&: فرأيتُ دمُوع جعفر بن مُحمّد تتحادرُ على خديه، وارتفع الصُراخ من داره حتّى أمرني بالإمساك.
وكان الإمامُ الصادق× إذا مرَّت عليه مصيبة يتذكّرُ مصيبةَ جدِّه الحسين×، ويُذِّكرُ بها أصحابَه، من ذلك: لمّا أمر المنصور الدوانيقي عاملَه على المدينة أن يحرق على أبي عبدالله الصّادق× داره، فجاؤوا بالحطب فوضعوه على باب دار الإمام وأضرموا فيه النار، فلمّا أخذت النارُ ما في الدهليز تصايحتْ العلويّاتُ داخلَ الدار، وارتفعت أصواتهُن، فخرج الإمام× وعليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، فجعل يُخمدُ النار ويُطفئ الحريق حتّى قضى عليها، فلمّا كان الغدّ دخل عليه بعضُ شيعتِه يسألونه فوجدوه حزيناً باكياً، فقالوا: مِمَّن هذا التأثّر والبكاء؟ أمن الجُرأة عليكم أهل البيت، وليس مِنهم بأولِ مرّة؟!
فقال الإمام×: لا، ولكن لمّا أخذتِ النار ما في الدهليز نظرتُ إلى نسائي وبناتي يتراكضن في صحن الدار من حجرةٍ إلى حجرة، ومن مكانٍ إلى مكانٍ، هذا وأنا معهُنَّ في الدار، فتذكرّتُ فرار عيال جدّي الحسين× يوم عاشوراء، من خيمةٍ إلى خيمةٍ، ومن خباءٍ إلى خباء، والمنادي ينُادي: أحرقوا بيوت الظالمين[48].
|
نادى ابن سعد حِرگوها
الخيام |
(بحراني)
من شبّوا النيران فَرّت كلّ العيال
بس العقيلة اتحيَّرت والدمع همَّال
نادى عدوها اشحيّرج يربات الادلال
نادى ومثل المطر يهمل مدمع العين
عدنه عليل إمن المرض ما يگدر ايگوم
نايم طريح وسادته بالخيم يا گوم
هُوّه البجيه من نسل هاشم ومخزوم
وهو الشريدة اللي بگت من نسل الحسين
***
|
ألا يا كرامَ الحي غبتُم جميعكم |
عتبتُ ولكن ما على الموت مَعتَبُ
|
يا وَقْعةَ الطّفِّ كم أوقدتِ في كبدي |
***
(هجري)
شيعتي نصبوا المآتم والعزا لمصيبتي
واذكروا التعفير خدّي بالتُراب اوذبحتي
لو شربتوا الماي اذكروني العطش فتّ مهجتي
واگصدوني الكربله والكلّ يسچب عبرته
لو تشوفوني يشيعه اعله الثره مرمي طريح
خدّي متوسّد ترايب والدمه منّي يسيح
شيعتي ولّي گطع ظهري اونحل مني الگوه
وحدتي من طاح يم النهر شيّال اللوه
شيعتي كثروا البچه حگي عليكم والنحيب
شفتوا مثلي بالخلگ مذبوح عطشان اوغريب
والچفن سافي يشيعه اوبالدمه شيبي خضيب
والحراير نصب عيني من خدرها امشتته
***
(مجاريد)
|
وين الّذي الهاشم يصلها |
(أبو ذية)
|
صدگ زينب يبو الحسنين تنساب |
***
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾[50].
لقد كانت سيرة رسول الله| قبل نزول سورة براءة (التوبة) أن لا يقاتل إلّا مَن قاتله، ولا يحارب إلّا مَن حاربه.
ولكن لمّا نزلت عليه سورة التوبة، وأمره تعالى بقتل المشركين، مَن اعتزله ومَن لم يعتزله، إلّا الّذين عاهدهم| يوم فتح مكّة إلى مُدّة، منهم: صفوان بن أُميّة وسهيل بن عمرو، فقال الله: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾، ثمّ يُقتلون أينما وجدوا بعد أشهر السياحة، وهي: عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعَشرةٌ من ربيع الآخر.
فلمّا نزلت الآيات من سورة براءة دفعها رسول الله| إلى أبي بكر وأمره أن يخرج إلى مكّة ويقرأها على النّاس بمنى يوم النحر، فلمّا خرج أبو بكر نزل جبرئيل على رسول الله| فقال: «يا محمّد لا يؤدّي عنك إلّا رجل منك».
فبعث رسول الله| أمير المؤمنين× في طلب أبي بكر، فلحقه بالروحاء[51] وأخذ منه الآيات، فرجع أبو بكر إلى رسول الله| فقال: يا رسول الله، أأنَزلَ الله فيَّ شيئاً؟ فقال: لا، إنَّ الله أمرني أن لا يؤدّي عنّي إلّا أنا أو رجل منّي[52].
ورُوِيَ عن حريز عن أبي عبد الله×: أنَّ رسول الله| بعث أبا بكر مع براءة على الموسم ليقرأها على الناس، فنزل جبرئيل فقال: لا يبلّغ عنك إلّا عليّ. فدعا رسول الله’ عَليّاً، وأمره أن يركب ناقته العضباء ويلحق أبا بكر فيأخذ منه براءة، ويقرأها على الناس بمكّة، فقال أبو بكر: أسخط؟ فقال: لا، إلّا أنّه أُنزل عليه أنّه لا يبلِّغ إلّا رجل منك. وفي رواية: ولمّا رجع أبو بكر إلى النبيّ’ جزع وقال: يا رسول الله، إنَّك أهّلتني لأمرٍ طالت الأعناق فيه، فلمّا توجّهتُ إليه رددتني منه؟ فقال’: «الأمين هبط إليَّ عن الله تعالى: أنّه لا يؤدّي عنك إلّا أنتَ أو رجلٌ منك، وعليٌّ منّي ولا يؤدّي عنّي إلّا عليُّ»[53].
وعزْلُ النبيّ’ لأبي بكر وبعْثُه لعليٍّ× إنّما كان بأمرٍ من الله نزل به جبرئيل×، ممّا يكشف عن المنزلة العظيمة الّتي يتمتّع بها الإمام أمير المؤمنين×.
وقد اختلف المفسرون في عدد الآيات التي بعثها النبيُّ الأكرم’ بيد الإمام أميرِ المؤمنين×، فقيل ثلاثين آية، وقيل أربعين، وقيل ثلاث عشرة آية[54].
وكيف كان، فإنَّ الآيةَ محل البحث (وهي آية 12) من السورة المباركة كانت من ضمن الآيات الّتي أمر الله بقراءتها على الحجّاج في السّنة التاسعة للهجرة، إلّا على قول مَن قال: إنَّ الآيات العشر الأُولى فقط هي الّتي كانت مورد التبليغ والإعلام[55].
والآية محل البحث جاءت ضمن آيات عرضها الباري} في السورة المباركة، حيث جاءت الآية المذكورة في مقابل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ﴾، أي لا يخلو الأمر من أحد وجهين:
فإمّا أن يتوبوا ويعرضوا عن الشرك، ويتّجهوا نحو الله.
وإمّا أن يستمروا على طريقهم ونكث أيمانهم. ففي الصورة الأُولى هم إخوانكم في الدين، وفي الصورة الثانية ينبغي مقاتلتهم[56].
والأمر بالمقاتلة جاء بعد الجملة الشرطية (النكث) و(الطعن)، بمعنى متى ما رأيت يا رسول الله هؤلاء الجماعة ـ من المخالفين لكم في العقيدة والمبدأ ـ قد نكثوا الأيمان والعهود، وطعنوا في دينكم، فلا مانع من قتالهم؛ لأنّهم هم الّذين بدؤوا باختيار طريق الحرب والقتل، بسوء اختيارهم وإرادتهم.
ما هو النكث والطعن في الدين؟
النكث في اللغة: هو نفس النقض، تقول: فلان نكث عهده إذا نقضه بعد إحكامه، كما ينكث خيط الصوف بعد إبرامه، ومنه قولُه تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ﴾. والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف والقسم[57].
وأمّا الطعن: فهو يأتي بمعانٍ متعدّدة، ولكن بما أنّه أُضيف إلى الدين فمعناه الإيقاع في الدين بالقول والقدح فيه[58].
وممّا يسترعي الانتباه أنَّ الآيات محل البحث لا تقول: (قاتلوا الكفّار) بل تقول: ﴿ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ﴾، وهي إشارة إلى أنَّ القاعدة الجماهيريّة وعامّة الناس تبعٌ لزعمائهم ورؤسائهم، فينبغي أن يكون الهدف القضاء على رؤسائهم وأئمّتهم؛ لأنّهم أساس الضلال والتضليل والظلم والغدر، فاستأصلوا شجرة الكفر من جذورها وأحرقوها، فمواجهة الكفّار لا تجدي نفعاً ما دام أئمّتهم في الوجود، أضف إلى ذلك أنَّ هذا التعبير يُعدُّ ضرباً من ضروب النظرة البعيدة المدى، وعلو الهمّة، وتشجيع المُسلمين؛ إذ عدُّ أئمّة الكفر في مقابل المسلمين، ليواجهوهم فذلك أجدر من مواجهة مَن دونهم من الكفّار.
والعجيب أنَّ بعضَ المفسّرين يرى أنَّ هذا التعبير يراد به أبو سفيان وأمثاله من زعماء قريش، مع أنَّ جماعةً منهم قُتلوا في معركة بدر، وأسلم الباقي منهم، كأبي سفيان بعد فتح مكة ـ بحسب الظاهر ـ وكانوا عند نزول الآية في صفوف المسلمين، فمقاتلتهم لا مفهوم لها.
واليوم ما يزال هذا الدستور القرآني المهم باقياً على قوّته (ساري المفعول)، فلكي نزيل الاستعمار والفساد والظلم لا بدّ من مواجهة الرؤساء والمتكبِّرين وأئمّة الانحراف، وإلّا فلا جدوى من مواجهة مَن دونهم من الأفراد[59].
مَن هم الناكثون؟
لقد اختلف المفسرون في تحقيق المراد من الناكثين في الآية المباركة، فذهب البعض إلى أنَّ المقصود هو أبو سفيان وأمثاله من زعماء قريش، وذهب البعض الآخر إلى أنَّ المراد اليهود والنصارى، وقال بعضهم إنّ المراد الفرس والروم.
أمّا كون المراد هو أبو سفيان وأمثاله، فقد تقدّم بيان تأخّر الآية عن وقت إسلامهم الظاهري، فلا يمكن أن تكون الآية ناظرة إليهم على وجه التحديد؛ لعدم شمول اللفظ لهم، ونزول الآية في السنة التاسعة للهجرة.
وأمّا كونهم الفرس أو الروم فهو بعيد جدّاً عن مفهوم الآية أو الآيات؛ لأنَّ الآية تتكلّم عن مواجهةٍ فعليّةٍ لا على مواجهات مستقبليّة. أضف إلى ذلك أنَّ الفرس أو الروم لم يهمّوا بإخراج الرسول من وطنه، كما أنَّ الاحتمال بأنّ المراد هم المرتدّون بعد الإسلام بعيدٌ غايَة البعد؛ لأنَّ التاريخ لم يتحدّث عن مرتدّين أقوياء واجهوا الرّسول ذلك الحين؛ ليقاتلهم بمَن معه من المسلمين.
ثُمَّ إنَّ كلمة (أيمان) ـ جمع (يمين) ـ وكلمة (عهد) يشيران إلى المعاهدة بين المشركين والرسول على عدم المخاصمة لا إلى قبول الإسلام[60].
وهناك روايات عديدة طبّقتِ الآية المباركة على أصحاب الجَمل من الناكثين وأمثال ذلك.
منها: ما عن حنان بن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: «دخل عليّ أناسٌ من أهل البصرة فسألوني عن طلحةَ والزُّبير، فقلت لهم: كانا من أئمّة الكُفر، إنَّ علياً× يومَ البصرة لمّا صفّ الخيل، قال لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حتّى أُعذر فيما بيني وبين الله} وبينهم، فقام إليهم، فقال: يا أهل البصرة، هل تجدون عليَّ جوراً في حُكم؟ قالوا: لا. قال: فحيفاً في قسم؟ قالوا: لا. قال: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم، فنقمتم عليّ فنكثتم بيعتي؟ قالوا: لا. قال: فأقمت فيكم الحدود وعطّلتها عن غيركم؟ قالوا: لا. قال: فما بال بيعتي تُنكث وبيعة غيري لا تُنكث، إنّي ضربت الأمر أنفه وعينه فلم أجد إلّا الكفر أو السيف.
ثُمَّ ثنى إلى أصحابه، فقال: إنَّ الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ﴿وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴾، فقال أمير المؤمنين×: «والّذي فلق الحبّة، وبرأ النسمة، واصطفى مُحمّداً’ بالنبوة، إنّهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا مُذ نزلت»[61].
وفي مضمونها هناك روايات أُخرى تشير إلى نفس المعنى المذكور[62]، ومجرّد تطبيق هذه الرواية وغيرها على الآية على أصحاب الجَمل لا يعني أنّها نزلت فيهم؛ لوضوح تقدُّم الآية على الحادثة، بل المقصود أنَّ روحَها وحكمها يصدقان في شأن الناكثين، ومَن هم على شاكلتهم، ممَّن سيأتون في المستقبل، وإنّما المقصود من الّذين نزلت فيهم الآية المباركة هم المشركون، الّذين نقضوا عهودهم الّتي أبرموها مع الرسول الأكرم’.
فالمقصود هم المشركون الّذين عاهدوا النبيَّ’ في الحُديبية ونقضوا، بأن أظهروا بني بكر على خزاعة، وقد كانت خزاعة في عهد النبي’ وبنو بكر في عهد قريش[63].
ولكن مع بيان أنَّ المقصود هؤلاء فهذا لا ينافي تطبيق الآية على كلّ مَن تمثّل بهم، ونهج منهجَهم، كما طَبّق ذلك الإمامُ أميرُ المؤمنين× على طلحة والزبير، أو الناكثين بصورة عامّةٍ، وروي ذلك عن الإمام الصّادق×.
وكذلك طَبّق الإمام الحسين× مضمون الآية على يزيد لعنه الله وحزبه الظالمين المخالفين الناكثين، وذلك عندما انطلق نحو العراق، ونزل بمكان يسمّى (بيضة) وخطب بأصحابه وأصحاب الحُرّ خُطبةً قال فيها: «أيّها الناس، إنَّ رسول الله’ قال: مَن رأى سُلطاناً جائراً مُستحلّاً لحرام الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يُغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يدخله مدخله، ألا وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشّيطان، وتركوا طاعة الرَّحمن، وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرامَ الله وحرَّموا حلاله وأنا أحقُّ من غيري»[64].
فالإمام يرى يزيدَ ـ لعنه الله ـ ومَن شابهه من أئمّة الكفر الّذين لا أيمانَ لهم وأنَّ قتالَهم واجبٌ، فالإمام× ترك مدينة جدّه المصطفى’ بهذه الصورة الواضحة عنده.
ولقد كان يوم خروج الإمام الحسين× من مدينة جدّه’ أعظم يومٍ على الهاشميين والهاشميات؛ إذ إنَّ الإمام الحسين× كان سلوةً لهم عن جدِّه رسول الله’ وعن أبيه أمير المؤمنين× وعن أخيه الحسين×، فأقبلت الهاشميات ونساء بني عبد المطّلب إلى دار الحسين×؛ لوداعه والتزوُّد منه ووداع عيالاته وأطفاله، فجعلن يبكين ويندبن، فمشى فيهنَّ الحسين× وقال: «أنشدكنّ الله، لا تبدين هذا الأمر لأنّه معصية لله ولرسوله. فقلن: يا أبا عبد الله، فعلى مَن تبقى النياحة والبكاء بعدك؟ وهذا اليوم عندنا كيوم مات فيه رسول الله’ وعليّ وفاطمة والحسن^، جعلنا الله فداك يا حبيب الأبرار». وبعد ذلك توجّه الإمام الحسين× إلى أُمِّ سلمة (رضوان الله تعالى عليها) وأخبرها بقتله، وقال لها: «يا أُمَّاه، وإنّي مقتول لا محالة، وليس لي من هذا بدّ، وإنّي والله، لأعرف اليوم الّذي أُقتل فيه وأعرف مَن يقتلني، وأعرف البقعة الّتي أُدفن فيها، وأعرف مَن يُقتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي، وإن أردت يا أمّاه، أريك حفرتي ومضجعي». يُقال: ثمّ أشار بيده الشريفة إلى جهة كربلاء، فانخفضت الأرض بإذنِ الله حتّى أراها مضجعَه ومدفنه وموضع عسكره، فعند ذلك بكت أمّ سلمة، وسلّمت أمرَها إلى الله. فقال لها الحسين×: «يا أُمَّاه، قد شاء الله أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً، وحرمي ورهطي ونسائي مسبيين وأطفالي مشرَّدِين»[65].
ثمَّ عرّج على قبر جدّه المصطفى’؛ ليودّعه ويتزوّد منه ويطلب منه أن يأخذه معه إلى اللحد، وكأنّي بالشاعر يصف ذلك، فيقول:
|
لمّن راد أبو السجّاد اوصارت تنتقم منه اخلص لو رحت وياك |
|
|
|
|
وصل ويلي الگبر جدّه اوبچه حسين |
|
***
|
أيُقتل السبط ظمآناً ومن دمِه |
المحاضرة الرابعة: مكارم الأخلاق
|
هذهِ دارُهُم تُهيجُ شُجوني |
(موشّح)
تَعتِب والعِتَب نار او سناها النوح
اوسيف العِتَب يترِك بالگلوب اجروح
الجسد لو فُگد روحه ينسلي اعلى الروح
وتراب البَلَه ايغيّر معانيّه
المعاني اتغيّرت واختلف وضع الحال
وَنَه زينب المنّي ما يلوح اخيال
چنت امخدّره واليوم خدري شال
وَعيش امخَدَّره باستار ماضيّه
أعيش امخدّره بأستار خدري الفات
لو مات الأَمل عِزّ الإبَه ما مات
هِدَم أركان بيتي هادم اللَذات
نِحَرته بالصَبر وَ شگف مَواضِيه
ششاگف آه من دنياي حيرتني
مراميها ابفگد ولياي صابتني
لو أشگف إسياط الوسِّمن متني
لو چلمة حچي اليگلون مسبية
(أبوذية)
|
علامة الدهر فرگنه علامة بچيت اوصاحتِ الوادم علامة |
***
قال رسول الله’: «عليكم بمكارم الأخلاق، فإنّ الله} بعثني بها، وإنَّ من مكارم الأخلاق: أن يعفو الرجلُ عمَّن ظلمه، ويُعطي مَن حرمه، ويصل مَن قطعه، وأن يعود مَن لا يعوده»[68].
في هذا الحديث يحثُّ النبيُّ الأكرم على أربعِ خصال لو اجتمعت في إنسان أصبح هذا الإنسان حاوياً لمكارم الأخلاق، وهذه المكارم ـ الّتي جاء بها الحديث ـ كُلُّها اجتمعت في الحسين بن علي‘، وهي:
1 ـ أن يعفو الرجلُ عمَّن ظلمه.
2 ـ ويُعطي مَن حرمه.
3 ـ ويصل مَن قطعه.
4 ـ وأن يعود مَن لا يعوده.
والإمام الحسين× هو الملبِّي لنداء الله تعالى في كلِّ دعوةٍ إلى خُلُقٍ فاضل حميدٍ، وهو أتقى الناس وأولى منهم بالفضائل، ومن هذهِ الفضائل العفو، حتّى أنَّه عفا عمَّن ظلمه لمّا كان قادراً على العقوبة فعفا، كجدّه المصطفى’ حين قال لأهل مكةَ: «اذهبوا فأنتم الطُلقاء»[69] من بعد ما آذوه أشدَّ الإيذاء، وصَدَرَ عفوه عن مقدرةٍ، فكان أحسن العافين.
روى ابن الصبّاغ المالكي: جنى بعض غلمان الحسين× «جنايةً توجب التأديب فأمر بتأديبه، فقال: يا مولاي، قال الله تعالى: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ﴾، قال×: «خلّو عنه فقد كظمتُ غيظي»، فقال: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾، قال×: «قد عفوت عنك»، فقال: ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾، قال: «أنت حُرٌّ لوجه الله تعالى». وأجازه بجائزةٍ سنيّة»[70].
فكان عفو الحسين×:
1 ـ مكافئة هنيئة على ذلك الغلام، فإنّه استعان بالقُرآن الكريم وخاطب به سيد الأخلاق مُعتمداً على كرمه وعفوه، فلم يُخيّبه الإمام الحسين×، بل صفح عنه، ثمّ قدّم له هديتين:
الأُولى: هي العتق، وأيّ هدية كانت! والثانية: جائزة سنيّة يستعين بها على العيش الحرّ الكريم.
فجمع الإمامُ الحسين× أكثر من خلُق: العفو، والتعليم، والكرم... وتلك هي أخلاقه سلام الله عليه متعدّدة في الموقف الواحد.
2 ـ أنَّه أكثر من عفوٍ، فليس هو مجرّد إسقاط حقّه من قصاص، بل كان إضافة إلى ذلك صفحاً جميلاً، والصّفحُ الجميل في قوله تعالى: ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾[71] هو: العفو من غير عِتاب، كما قال الإمام الرضا×[72].
هذا عفو الحسين× الّذي وَرِثَه من جدّه المصطفى’.
وتعال الآن إلى النقطة الثانية في الحديث، وهي: «ويُعطي مَن حرمه»؛ لأنّ الّذي يعطي مَن أعطاه لافضل فيه، فهو كالّذي يُعطي مَن سأله؛ ولذا روي عن الإمام أمير المؤمنين× أنَّه قال: «السخاء ما كان عن إبتداء، فأمّا ما كان عن مسألةٍ فحياءٌ وتذمّم»[73] يعني الإنسان عندما يُعطي المحتاج يعطيه قبل أن يسأله، فالحسين× مدَّ يدَه إلى القاصي والداني في رحمته، العدوّ والصديق، المخالف والمؤالف، فهو لا يمنع كرمَه، ولا يقفُ كرمُه عند حدٍّ مُعين (سلام الله عليه).
وكذلك كان×: «يصل مَن قطعه». زيارة المؤمنين مُستحبّة، حتى إنّه جاء في الرواية استحباب التجمّل والخروج لزيارة المؤمنين[74]، خاصّة إذا كان في الزيارة نفع يعود على الزائر وعلى المزور، يعني أن يكون المجلس خالي من المُحرّمات، كالغِيبة الّتي تكثر في المجالس ـ نستجير بالله ـ والحسين× الّذي تُعقد عليه المجالس والمآتم، ونلطم عليه الصدور لا يقبل لأحد بأن يغتاب أخاه المؤمن؛ لأنّ الغيبةَ عند الله أشدُّ من الزّنا، كما روي عن النبيّ الأكرم’[75]. ولكن أحياناً نجد بعض المؤمنين أنت تزوره وهو يقطعك، ولعلَّك تُكرّر عليه الزيارات مراتٍ، وهو إمّا قد يأتيك مرّة واحدة حياءً منك، أو حتى لا يأتي مرةً واحدة. في هذه الرواية الّتي جاءت على لسان رسول الله’ أنّك لا تقاطعه خاصّة في الأرحام، الله الله في الرَّحم، الله الله في الأبوين، رفقاً بإخوانكم وأخواتكم، رفقاً بنسائكم؛ فانَّ الزوجةَ عند زوجها كالأمة[76] لا تستطيع أن تقوم بأي شيء. فلنقتدي بأخلاق الحسين وآل الحسين^. دعونا نستفِد من أيام عاشوراء، أيام عاشوراء ليست عَبرة فقط، بل فيها عِبَر لأنَّ الحُسين× كما أنّه عَبرة كلّ مؤمنٍ فأنّه عِبرة لكُلِّ مؤمنٍ أيضاً، يعني نستغلُّ هذه الأيام (عشرة مُحرّم) نستمع إلى سيرة أهل البيت^، نستفيد من الحسين× الغيرة على الدين وعلى العِرض، نستفيد منه السخاء، نستفيد منه التواضع، نستفيد منه الشجاعة، وما إلى ذلك من الفضائل الحُسينيّة القُدسيَّة. ولنرجع إلى النقطة الثالثة وهي: (أن يصل مَن قطعه) فإذا قاطع أحدٌ الحُسينَ× تراه لا يقطعه، كما فعل أمير المؤمنين× في معركة صفّين مع معاوية، فالماء كان عند أصحاب الإمام× فبعث الإمام أمير المؤمنين× إلى معاوية× قائلاً: «إنّا لا نكافيك بصُنعِكَ، هلُهمَّ إلى الماء، فنحن وأنتم فيهِ سواء»[77] ولكنَّ أعداء الإمام وهم معاوية وجيشه لمّا ملكوا الماء في بداية الأمر لم يسقوا الإمام وأصحابه منه[78].
|
مَلَكْنا فكان العفوُ منّا سجيةً ولمّا ملكتُم سال بالدمِ أبطحُ |
«وأن يعود مَن لا يعوده»، العيادة: تعني زيارة المريض الّتي هي من الأُمور الأخلاقية السامية، وزيارة المريض وما فيها من الأجر والثواب، ممّا لا يعلمه إلّا الله، ورسولَه| وأهل بيته^[80]، فعلى الإنسان أن لا يقاطع أخاه الإنسان الّذي كان لا يعوده في مرضه، يعني: عِندما كنتُ أمرض لا يزورني، فعِندما يمرض هو فلا يصحّ أن أفعل كفعله أيضاً، أي: لا أزوره.
يقول رسول الله’: «عليكم بمكارم الأخلاق»، وواحدة من مكارم الأخلاق هي عيادة المريض حتى ولو كان قد قاطعك ولم يَعدك في مرضك، أنت مؤمن تقصد وجه الله تبارك وتعالى ولم تقصد وجه الناس، أقبل إلى ذلك الوجه الكريم الّذي يكفيك وجوه الناس كُلّها، فإذا كان الأمر كذلك ـ أي: تقصد وجه الله تبارك وتعالى ـ فلا يهمّك الأمر، فأنت لا بدّ أن تعوده لله بنيّة صادقة وتُدخلُ على قلبه السّرور.
وهُناك عِيادة حصلت للحسين× ـ لأنَّ الحسين كان مريضاً في يوم عاشوراء من سهام القوم وطعنات الأعداء ـ وهي عيادة أُمّهِ الزهراء‘ فلم تكن السّيدة الزهراء‘ غائبةً عن مأساة كربلاء، بل كانت حاضرةً بروحها يومَ العاشر من المحرّم، وشاهدت تلك المشاهد المروعة من عطش الأطفال، وذبحهم، وقتل الحُسين× وأصحابه، إلى سبي النساء، وفصل الرؤوس عن الأجساد، وكانت تنتقلُ مع رأس الحسين× من مكانٍ إلى مكانٍ، ومن بلدةٍ إلى بلدةٍ، ولهذا يُروى: أنّ سُكينة بنت الحسين‘ قالت: «لمّا كان اليوم الرابع من مقامِنا بدمشق (في الخربة)، رأيتُ في المنام امرأةً راكبةً في هودجٍ، ويدها موضوعة على رأسها، فسألتُ عنها، فقيل لي: هذه فاطمة بنتُ محمدٍ’ أُمُّ أبيك. فقلتُ: والله، لأنطلقَّن إليها ولأخبرنها ما صُنع بنا، فسعيتُ مبادرةً نحوها حتّى ألحقتُ بها، فوقفت بين يديها أبكي وأقول: يا أُمّاه جحدوا حقّنا، يا أًمّاه، بدّدوا والله شملَنا، يا أُمّاه، إستباحوا والله حرمَنَا يا أُمّاه قتلوا والله الحُسينَ أبانا. فقالت: كُفِّي صوتَكِ يا سُكينة، فقد قُطّعت نياط قلبي، هذا قميص أبيك الحسين لا يُفارقني حتى ألقى الله به»[81]، ورحم الله شاعر أهل البيت^ حيث يقول:
|
لا بُدَّ أن تردَ القيامةَ فاطمُ وقميصُها بدمِ الحُسينِ ملطّخُ |
ولذا يقول الإمام الباقر× في حديث طويل: «ثُمَّ إنَّ فاطمةَ تأخذ قميص الحُسين ملطّخاً بالدم، وتقول: إلهي، احكُم بيني وبين مَن قتل ولدي، ثمّ يُقالُ لها: اُنظُري في قلب القيامة فترى الحُسين× قائماً مقطوع الرأس، فإذا رأته صرخت وولولت: وا ثمرة فؤاداه، فتُصعق الملائكة لصيحتها، وينُادي أهلُ الموقف: قتلَ الله قاتلَ ولدِك»[83].
أقول: يا شيعي، يا موالي، يا مُحبَّ الحُسين هذا القميص الّذي تأتي به الزهراء يوم القيامة هو ذلك القميص الّذي «صار كالقنفذ من شدّة السهام».
|
ثگل ما يندره ابنشابها منين يجيه
اوزانها يخطف على احسين |
الله أكبر، الله أكبر...
قد يتعجب البعض كيف يكون الحُسين قد أصابه من الجُروح هذا العدد الكبير؟! لا تعجبوا؛ لأنّ أكثر من خمسمائة رامٍ قد وجّهوا سهامهم نحو الحُسين، وهو مُلقًى على الأرض يجود بنفسه متقرِّبين بذلك إلى عُبيد الله بن زياد.
|
وهو يُفكّر بحالةِ ذيچ
العيال شلون اتظل يساره بيد الأنذال |
(أبوذية)
|
دليلي إمصوّب اومحتار بلهام برزية كربلا ما ركن بلهام |
***
|
هوى هيكل التوحيد فيه على الثرى غداة هوى القصـر المشيد المعظّم |
المحاضرة الخامسة: عِلم الإمام ×
|
كم يا هلالَ مُحرّمٍ تُشجينا ما زال قوسُك نبلُه يَرمينْا |
وكأنّي بأُمّه الزّهراء‘ تسأله عن الّذي صنع به ما صنع فتقول:
(بحراني)
تناديه يبني من گطع راسك والچفوف
من كسّر إضلوعك يعقلي بأرض الطفوف
ومن گطّع أوصالك يعيني ابضـرب السّيوف
يا مُهجتي مذبوح لا مطلب ولا دين
يحسين گلي من گطع بالسّيف نحرك
يا نور عيني من وطا بالخيل صدرك
ومن سلّب أيتامك أو ياهو حرك خدرك
وياهو الذي شتت بناتي شمال ويمين
***
|
أنا الوالدة والگلب لهفان أدور عزه ابني وين ما چان |
***
قال الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾[86].
معناه أنّه سُبحانه حكم بأن يُظهر هذا التمييز، يعني الآية التي قبل هذا المقطع من هذهِ الآية المباركة، وهو ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾إلى أن يصل الدور إلى هذا المقطع، وهو أنّه لايجوز أن يحصل ذلك التمييز ـ بين الخبيث والطيّب ـ بأن يُطلعكم الله على غيبه، فيقول: إنّ فلاناً منافق، وفلاناً مؤمن، وفلاناً من أهل الجنّة، وفلاناً من أهل النار، فإنّ سنّة الله جارية بأن لا يطلع عوام الناس على غيبه، بل لا سبيلَ لكم إلى معرفة ذلك إلّا بالإمتحانات، مثل وقوع المحن والآفات حتّى يتميّز عندها الموافق من المنافق، فأمّا معرفة ذلك على سبيل الاطّلاع على الغيب فمن خواصّ الأنبياء؛ لهذا قال ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾، أي: ولكنَّ الله يصطفي من رُسُله مَن يشاء فيخصّهم بإعلامهِم أنَّ هذا مؤمن وهذا منافق[87].
هذا معنى. وهناك معنى آخر: وهو وما كان الله ليؤتي أحداً منكم على الغيب، فلا تتوهموا عند إخبار الرّسول’ بنفاق الرّجُل وإخلاص الآخر، أنّه يطّلع على ما في القلوب اطّلاع الله تعالى، فيخبر عن كُفرها وإيمانها، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ﴾ يرسِلُ الرّسول فيوحي إليه ويخبره بأنّ في الغيب كذا، وأنّ فلاناً في قلبه النفاق، وفلاناً في قلبه الإخلاص، فيعلم ذلك من جهة إخبار الله، لا مِن جهة اطّلاعه على المُغيّبات[88].
إذن كان الاطّلاع على الغيب إخبار مِن الله تبارك وتعالى للرُّسل، ومِنهم ـ بل في طليعتهم ـ النبيّ الأكرم’.
ثمّ يُسجّل التّدليل عليه بقوله كُلّما كان لرسول الله’ فلنا مثله، إلّا النبوّة والأزواج، ولا غلوَّ في ذلك بعد قابلية تلك الذّوات المُطهَّرة بنصّ الذّكر الحكيم في ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾[89] لتحمّل الفيض الأقدس وعدم الشحّ في المبدأ الأعلى، تعالت آلاؤه، والمغالاة في شخصٍ عبارة عن إثبات صفة له، إمّا أن يتحمّلها العقل أو لا؛ لعدم القابلية لها، والعقل لا يمنع الكرم الإلهي، كيف؟! والجليل عزّ لُطفه يدرّ النّعمَ على المُتمادين في الطغيان والمتمرِّدين على قدس جلاله، حتّى كأنَّ المنّة لهم عليه، فلم يمنعه ذلك من الرحمة بهم والإحسان إليهم والتفضّل عليهم؟![90]، ولا تنفذ خزائنه ولا يفوتُه من طلبه، وهذا من القضايا الّتي قياساتُها معها، وإذا كان حال المهيمن سُبحانه كما وصفناه مع أُولئك الطُغاة، فكيف به مع مَن اشتقّهم من الحقيقة الأحمديّة الّتي هي من الشُعاع الأقدس جلَّ شأنه، فالتقى مبدأ فيّاض وذوات قابلة للإفاضة، فلا يدع في كُلِّ موردٍ في حقّهم^ من علم الغيب، والتفوّق على أعمال العباد، وما يحدث في البُلدان ممّا كان وما يكون.
فالغيب المدّعى فيهم^ غير المختصّ بالباري تعالى؛ لاستحالته في حقّهم^، فإنّه بالنسبة لله تعالى شأنه ذاتيّ، وأمّا بالنسبة للأئمّة^ فهو مجعول من الله سُبحانه وتعالى، فبواسطة فيضه تعالى ولطفه كانوا يتمكّنون من استعلام خواص الطّبائع والأحداث.
فأذن الغيب على قسمين: منه ما هو عين واجب الوجود بحيث لم يكن صادراً عن علّةٍ غير ذات فاطرِ السّموات والأرضين، ومنه ما كان صادراً عن علّةٍ ومتوقّفاً على وجود الفيض الإلهي، وهو ما كان موجوداً لدى الأنبياء والأوصياء. وإلى هذا يشهد ما جاء عن أبي جعفر الجواد×، فإنّه لمّا أخبَر أُمَّ الفضل بنت المأمون بما يجرى على النّساء عند الحيض قالت له: لا يعلم الغيب إلّا الله، قال×: «وأنا أعلمُ من عِلمِ الله تعالى»[91]، وهناك شواهد كثيرة على هذا المعنى.
وأمّا ما ورد عنهم^ من نفي علمهم بالغيب، كقول أبي عبد الله×: «يا عجباً، لأقوامٍ يزعمون إنّا نعلمُ الغيبَ، ما يعلم الغيب إلّا الله، لقد هممتُ بضرب جاريتي فهربت منّي ما علمتُ في أيِّ بيوت الدار»[92]، فهو محمول على التقيّة، لحضور بعض النفر ممَّن لم تكن لهم القابلية على تحمّل غامض علم أهل البيت^، فأراد أبو عبد الله× أن ينفي علم الغيب عنهم^؛ تثبيتاً لعقيدة هؤلاء.
ويؤيّدُه أنَّ سديراً الراوي لهذا الحديث دخل عليه في وقتٍ آخر، وذكر له استغراب ما سمعه منه من نفي العلم بالغيب، فطمأنه بأنّه لَيَعلمَ ما هو أرفع من ذلك وأرقى، وهو العلم بالكتاب كُلِّه وما حواه من فنون المعارف وأسرارها.
وأمّا الحكاية عن النبيِّ| في القرآن الكريم: ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾[93] فلا يفيد إلّا كونه مفتقراً إلى الله تعالى في التعليم، وأنّه لم يكن عالماً بالغيب من تلقاء نفسه، وهذا لا ريب فيه.
إذن المنفي في الآيات اطّلاعُه على الغيب من غير واسطة، وأمّا علمَه بالغيب بإعلام الله تعالى فثابتٌ ومتحقّقٌ؛ لقوله تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ﴾[94].
نعم لقد آثر الله تباركَ وتعالى بعضَ العلوم لنفسه، ولم يُطلع عليها أحداً أبداً، كالعلم بالسّاعة.
فلقد تجلَّى بما ذكرناه وبيّناه أنَّ العقل والشرع يجوزان للمعصوم أن يعلم الغيب.
ومن موارد علمهم^ بالغيب علم الإمام الحسين× بشهادته وما سيجري عليه وعلى عيالاته وأطفاله، من محنٍ ومصائب تَنهَدُّ منها الجبال وتكاد الأرض أن تنشقّ لعظمتها، حيث أخبر× وقال: «والله، ليجتمعنَّ على قتلي طُغاةُ بني أُميّة ويقدمهم عُمر بن سعد»[95]، وليس في إقدامِهم^ على الشهادة إعانة على إزهاق نفوسهم القدسيّة وإلقائها في التهلُكَة المحظورة والمنهي عنها بنصّ الذكر الحكيم؛ فإنّ الإبقاء والحفاظ على النفس والحذر عن إيرادها مورد الهلكة إنّما يجب إذا كان مقدوراً لصاحبها، أو لم يُقابل بمصلحةٍ أهمّ من حفظها، وأمّا إذا وجدت هنالك مصلحةٌ تكافئ تعريض النفس للهلاك، كما في الجهاد والدفاع عن النفس، فهنا يرتفع محذور الهلكة. فالهلكة التي ذكرها القُرآن الكريم هي من الأحكام المُختصّة بما إذا لم تكن هُناك مصلحة أقوى من مفسدة الإقدام على التّلف، ومع وجود المصلحة اللازمة لا يتأتّى الحُكم بالحُرمة أصلاً، كما في الدّفاع عن بيضة الإسلام، الذي أفتى بعض الفقهاء في وجوبه، كما هو ظاهر لمَن راجع أقوالهم وفتاواهم (قدس الله تعالى أرواحهم)[96].
فالعقل والشرعُ يحبّذ الإقدام على الهلكة إذا تحققت به مصلحة تقاوم مفسدة الهلكة، من إبقاء دينٍ وشريعةٍ، أو إبراز حقيقة لا تظهر إلّا به، كما في أمر الإمام الحسين× يوم وقف ذلك الموقف المدهش فتلا على الملأ صحيفة بيضاء رتّلتها الحُقبُ والأيّام والأعوام.
فلقد عرّى × بنهضته المقدّسة حقيقة الأمويين للأُمم الحاضرة والمتعاقبة، وكان× يعتقد في نهضته أنّه فاتحٌ منصورٌ لما في شهادته من إحياء دين رسول الله| وإماتةَ البدعة، وفضح أعمال المناوئين، وتفهيم الأُمّة أنَّ أهل البيت^ أحقّ بالخلافة من غيرهم، وإليه يشير في كتابه إلى بني هاشم: «مَن لحق بي منكم استشهد، ومَن تخلّف لم يبلغ الفتح»[97]. فإنّه× لم يرد بالفتح إلّا ما يترتّب على نهضته وتضحيته من نقض دعائم الضّلال، وكسح أشواك الباطل عن صِراط الشريعة المُطهّرة، وإقامة أركان العدل والتوحيد، وأنّ الواجب على الأُمّة هو القيام في وجه المُنكر.
وهذا معنى كلمة الإمام زينِ العابدين× لإبراهيم بن طلحة بن عبد الله لمّا قال له: مَن الغالب؟ فقال الإمام السجّاد×: «إذا دخل وقت الصلاة فأذّن وأقم تعرف الغالب»[98].
فإنّه× يُشير إلى تحقق الغاية التي ضحّى سيّد الشُهداء بنفسه القدسية لأجلها، وفشل يزيد بما سعى له من إطفاء نور الله تعالى، وما أراده أبوه من نقضِ مساعي الرسول|.
ولذا تجد الحُسين× ذكر أنّه يُقتل وتُسبى عيالاتُه، وحصل ما حصل بالفعل في يوم عاشوراء، فقام خطيباً قبل أن يخرج إلى العراق، فقال: «كأنّي بأوصالي تُقطّعها عُسلان الفلواتِ بين النواويس وكربلاء، فيملأن منّي أكراشاً جُوفاً وأجربةً سغباً»[99].
رُوي أنّه لمّا أراد الخروج من المدينة توجّه إلى قبر جدّه ليودّعه، فأقبل نحوه، فصلّى ركعتين عند قبر جدّه، ثُمَّ رفع طرْفه نحو السّماء، ثُمَّ صفّ قدميه، فلم يزل قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً حتّى الصّباح، ثُمَّ عاد في اليوم الثاني، فبكى عند قبر جدّه المُصطفى، يبكي ويبكي إلى أن هوّمت عيناه، وإذا به يرى جدّه رسولَ الله’ في كتيبةٍ من الملائكة ورعيلٍ من الأنبياء، فضمّ الحُسين× إلى صدره وقال: «بُني حسين، كأنّي بك عن قريبٍ مذبوحاً بأرض كربٍ وبلاءٍ، بين عُصابة من أُمّتي، لا أنالهم شفاعتي، وأنت عطشانٌ لا تُسقى وظمآن لا تُروى، بُني حُسين، إنَّ أمَّك وأباك وأخاك قدموا عليّ وهم مشتاقون إليك فالعجل العجل».
قال الراوي: «فصار الحسين× ينظرُ في منامه إلى جدّه رسول الله’ ويبكي ويقول: ياجدُّ لا حاجةَ لي في الرُجوع إلى الدُنيا خُذني مَعك، أدخلني في قبرك؛ أستريح من هذه المصائب! فقال له جدّه رسول الله|: يا بنيّ يا حسينُ، لا بُدَّ من الرجوع إلى الدُنيا حتّى تذوق الشهادة، فتنال ما قد كتب الله لك من الأجر العظيم والمنازل الرفيعة والدرجات العالية»[100].
آه آه:
ضُمنّي عندك يا جدّاه في هذا الضـّريح
علّني يا جدُّ من بلوى زماني أستريح
ضاق يا جدُّ من رحب الفضا كلّ فسيح
فعسى طود الأسى يندكّ بين الدكتين
جدّ صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب
وأشاب الهمُّ رأسي قبل إبّان المشيب
فعلا من داخل القبر بُكاءٌ ونحيب
ونداء بافتجاعٍ يا حبيبي يا حُسين
ستذوق الموت ظُلماً ظامياً في كربلا
وستبقى في ثراها ثاوياً مُنجدلا
وكأنّي بلئيمِ الأصل شمرٍ قد علا
صدرَك الطاهِرَ بالسّيف يحزّ الودجينِ
(نعي)
|
وصل ويلي الگبر
جدّه وبچه حسين |
***
(تخميس)
|
يا من له فصلُ الخلائقِ صائرُ وعليه قطبُ رحى الجلالة دائرُ |
وحـُسيـن مـطـروحٌ بـعرصـةِ كربلاء
المحاضرة السادسة: بين كربلاء والكعبة
إنْ كُنتَ مَحزوناً فما لكَ ترقُدُ |
***
(موشّح)
يا تالي هلي يحسين يا سلوةَ هلي يحسين
سهم الصابك ابگلبك تره صوّب إلگلب الدين
لا بعدك يجفّ دمعي ولا يهده اوتنام العين
ليل انهار أنَه ابهمّك اوهمّك لا بعد ينزاح
يا تالي هلي يحسين يا صبري على بلواي
يبن أميّ احترمت الماي عگبك لا شربت الماي
يا تالي هلي يحسين من بعدك بعد تدري
لا شمس وبدر يا ليت لا عذب الهوة يسـري
لا دنيه اوفلك دوّار لا ماي الّذي يجري
عسه شط الفرات ايغور لا يطفح عسه اولا فاح
***
(مجاريد)
|
يحگلي لنوح الدهر كلّه |
***
(أبو ذية)
|
المصيبة حلّت اعلينه وترها |
***
روي عن الإمام الحسين× أنّه قال لابن الزبير: «لئن أُدْفن بشاطي الفرات أحبُّ إليَّ من أن أُدفن بفناءِ الكعبة»[102].
سؤال لطالما يُطرح على العقول، وهو لماذا توجّه الإمام الحسين× إلى العراق؟
وأفضل مَن أجاب عن هذا السؤال هو الإمام الحسين× نفسه، ويمكننا هنا التعرُّف على أبعاد هذا الجواب، وتحديد العوامل الّتي دفعت الإمام× إلى اختيار العراق لا غيره من البلدان، من خلال تتبُّع واستقصاء جميع ما أُثرَ من تصريحات الإمام× في هذا الصدد، منذ إعلانه عن قيامه المقدّس في رفض البيعة ـ ليزيد بعد موت معاوية ـ أمام الوليد بن عتبة والي المدينة آنذاك حتى أواخر ساعات حياته في كربلاء في احتجاجاته على أعدائه قبيل نشوب القتال يوم عاشوراء.
وعلى ضوء تصنيف تصريحاته× على أساس نوع الإشارة فيها، يمكننا تحديد العوامل الّتي دفعت الإمام× إلى هذا الأمر.
وهذه العوامل هي:
1ـ العراق مهد التشيّع ومركز معارضة الحكم الأُموي:
وذلك حين إجابته× عن سؤال عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة بالأبواء ـ بين المدينة ومكَّة ـ أين تريد يا بن فاطمة؟
قال الإمام×: «العراق وشيعتي»[103]، عِلماً أنّ هذه المحاورة تمّت بالأبواء قبل وصول الإمام× إلى مكّة، أي قبل وصول رسائل أهل الكوفة إليه.
ونفهم ذلك أيضاً من خلال محاورة جرت بينه× وبين عبد الله بن عبّاس، قال ابن عباس: فإن كنت على حال لا بدَّ أن تشخص فصِر إلى اليمن؛ فإنَّ بها حصوناً لك وشيعةً لأبيك فتكون منقطعاً عن الناس!
فقال الإمام×: «لا بدَّ من العراق!»[104].
هذان النصّان ـ ونظائرهما ـ يكشفان بوضوح عن أهميّةِ العراق بذاته عند الإمام×، وبمعزلٍ عن أثر رسائل أهل الكوفة الّتي وصلت إلى الإمام× في مكّة بعد موت معاوية، وأهميّة العراق بذاته عند الإمام× من الحقائق التاريخيّة الّتي لا تحتاج لإثباتها إلى الاستشهاد عليها بنصّ.
فلقد كانت الكوفة مهداً للشيعة، وموطناً من مواطن العلويين، وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت^ في كثيرٍ من المواقف، وقد خاض الكوفيون حرب الجَمل وصفّين مع الإمام، وكانوا يقولون له: سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت، فنحن حزبك وأنصارك. وكان الإمام أمير المؤمنين× يثني عليهم ثناءاً كبيراً، فيرى أنّهم أنصاره وأعوانه المخلصون له، يقول لهم: «يا أهل الكوفة، أنتم إخواني وأنصاري وأعواني على الحقِّ ومجيبي إليَّ جهاد المحلين، بكم أضربُ المدبر وأرجو إتمام طاعَةِ المُقبِل»[105].
وكانت الكوفة بعد أمير المؤمنين× والإمام الحسين× المقرَّ الرئيسي لمعارضة الحكم الأُموي، وكان الكوفيون يتمنّون زوال الحكم الأُموي، وكان الشيعة في العراق ـ بعد شهادة الإمام الحسن× ـ على اتّصال بالإمام الحسين× من خلال المكاتبات واللقاءات، ونكتفي للدّلالة على ذلك بهذين النصّين:
الأوّل: نقل الشيخ المفيد& عن الكلبي والمدائني وغيرهما من أصحاب السير، أنّهم قالوا: «لمّا مات الحسن× تحرّكت الشّيعة بالعراق وكتبوا إلى الإمام الحسين× في خلع معاوية والبيعة له، فامتنع عليهم وذكر أنّ بينه وبين معاوية عهداً وعقداً، لا يجوز له نقضه حتّى تمضي المُدّةُ، فإذا مات معاوية نظر في ذلك»[106].
الثاني: رُوي أنَّ الوليدَ بن عتبة حجَب أهلَ العراق عن الإمام الحسين×، فقال الإمام الحسين×: «يا ظالماً لنفسه، عاصياً لربّه، علامَ تحول بيني وبين قومٍ عرفوا من حقّي ما جهلته أنتَ وعمُّك؟!»[107].
2 ـ العراق أرض المصرع المختار:
لمّا عزم الإمام الحسين× على الخروج من المدينة أتته أُمُّ سلمة (رضوان الله تعالى عليها) فقالت: يا بُنيَّ، لا تحزنّي بخروجك إلى العراق، فإنّي سمعتُ جدَّك يقول: «يُقتلُ وَلَدي الحُسين× بأرض العراق في أرضٍ يقال لها كربلاء!»
فقال لها: «يا أُمّاه، وأنا والله، أعلم ذلك، وإنِّي مقتول لا محالة، وليس لي من هذا بدٌّ، وإنّي والله، لأعرفُ اليومَ الّذي أُقتل فيه، وأعرف مَن يقتلني، وأعرف البقعة الّتي أُدفن فيها، وإنِّي أعرف مَن يُقتل من أهل بيتي وقرابتي وشيعتي، وإن أردتِ يا أمّاه أرُيكِ حفرتي ومضجعي»[108].
وفي رواية أُخرى أنَّه قال لها: «والله، إنّي مقتول كذلك، وإن لم أخرج إلى العراق يقتلوني أيضاً»[109].
وقد روي بأسانيد أنَّه لمّا منعه× مُحمّدُ بنُ الحنفية عن الخروج إلى الكوفة قال: «والله يا أخي، لو كنتُ في جُحر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتّى يقتلوني»[110].
وفي روايةٍ أنّه× قال لابن الزبير: «ولئن أُقتلُ بالطّف أحبُّ إليَّ من أن أُقتل بالحرم»[111].
هذه النصوص ـ ونظائرها ـ تكشف لنا أنَّ الإمامَ× منذ البدء كان قد اختار العراق أرضاً لمصرعه.
ولعلَّ سرّ ذلك هو أنَّ الإمام× ـ بعد إن اختار موقفه المبدئي برفض البيعة ليزيد وبالقيام ـ كان يعلم منذ البدء أنَّه مقتول لا محالة ـ خرج إلى العراق أو لم يخرج ـ فكان من الحكمة أن يختار الإمام× لمصرعه أفضل الظروف الزمانية والمكانية والنفسية والاجتماعية المساعدة على كشف مظلوميته، وفضح أعدائه، ونشر أهدافه، وأنَّ يتحرّك باتّجاه وتحقيق ذلك ما وسعته القدرة على التحرّك، وبما أنَّ الإمام× كان يعلم منذ البدء أيضاً أنَّ أهل الكوفة لا يفون له بشيءٍ من عهدهم وبيعتهم، وأنّهم سوف يقتلونه: «هذه كتب أهل الكوفة إليَّ ولا أراهم إلّا قاتليّ»[112]، فهو× مع هذا ـ بمنطق الشهيد الفاتح ـ كان يريد العراق ويصرُّ على التوجّه إليه؛ لأنَّه أفضل أرض للمصرع المختار؛ ذلك لما ينطوي عليه العراق من استعدادات للتأثّر بالموت العظيم (واقعة عاشوراء).
ويكفي في ذلك قوله لمَّا سأله ابنُ عبّاس: أين تريد يابن فاطمة؟
فأجاب×: «العراق وشيعتي!»[113] وقوله لابنِ عبّاس: «لا بدَّ من العراق»[114].
3 ـ رسائل أهل الكوفة بعد موت معاوية:
ما إنْ علِمَ أهلُ الكوفة بموت معاوية بن أبي سفيان، وأنَّ الإمام الحسين× قد رفض البيعة ليزيد، وقد خرج من المدينة وأقام في مكّة، حتّى تقاطرت إليه رُسُلُهم ورسائلهم يدعونه إليهم، مُظهرين استعدادهم لنصرته والقيام معه، حتّى إنّه اجتمع عنده اثنا عشر ألف كتاب، ووردت إليه قائمة فيها مائة وأربعون ألف اسم، يعربون عن نصرتهم له حالما يصل إلى الكوفة، فكان سفيره إليهم مسلم بن عقيل× قد كتب إلى الإمام× ـ بعد وصوله إلى الكوفة وأخذ البيعة له منهم ـ قائلاً: «أمّا بعد فإنَّ الرائد لا يكذبُ أهلَه، وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاً، فعجّل الإقبال حينَ يأتيك كتابي فإنَّ النّاس كلّهم معك، ليس لهم في آل معاوية رأيٌ ولا هوًى والسّلام»[115].
وكان أهل الكوفة في آخر وفادتهم إلى الإمام× في مكّة قد كتبوا إليه يقولون: «أمّا بعد، فإنَّ النّاس ينتظرونك، لا رأيَ لهم غيرك، فالعجلَ العجلَ يابنَ رسول الله، فقد اخضرّت الجنّات، وأينعت الثمار، وأعشبت الأرض، وأورقت الأشجار»[116].
لقد شكّلت رسائل أهل الكوفة حُجّةً على الإمام× في وجوب الاستجابة لهم، وقد كان الإمام× قد علّق عزمه في التوجّه إلى الكوفة على التقرير الميداني لمُسلم بن عقيل× عن حال أهل الكوفة، وقد صدّر× لأهل الكوفة في رسالته الأُولى إليهم بذلك، حيث قال: «فإن كتب إليّ أنّه قد اجتمع رأي ملأِكم وذوي الحجى والفضل فيكم على مثل ما قَدِمت به رسلُكم، وقرأت في كتبكم، فإنّي أقدمُ إليكم وشيكاً إن شاء الله»[117].
وعلى ضوء رسالة مسلم× عقد الإمام الحسين× عزمه على التوجّه إلى الكوفة، محتجّاً برسائلهم إليه، واحتجاجاته× برسائل أهل الكوفة إليه كثيرة، منها: قوله لابن عمر ـ وكان قد نهاه عن التوجّه إلى أهل العراق ـ: «هذه كتبهم وبيعتهم»[118] وغيره.
ولا يقال: لماذا أنَّ الإمام لم يرجع بعد ما قُتل مسلم بن عقيل× وظهرت أمارات الخذلان؟
فإنّه يُقال: إنَّ تأثيرَ الإمام× إذا كان بين أهل الكوفة يكون أكبر، واهتمامهم به أكثر، كما أشار إلى ذلك بعضُ أصحاب الإمام الحسين×، حيث قال: «إنّك والله، ما أنتَ مثل مسلم بِنِ عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع»[119]، ولذا واصل الإمام× الإصرار على التوجّه إلى الكوفة حتّى بعد مقتل مسلم×.
لكنَّ التاريخَ يثبت أنَّ الإمام× لم يعتمد هذا النظام ولم يتحرّك على أساسه، لعلمِه× بما سيؤول إليه موقف أهل الكوفة من قبل ذلك.
فلا يبقى مجال إلّا أن نقول إنَّ الإمام واصل التزامه بالوفاء بهذا الوعد وهذا القول، وأصرّ على التوجّه إلى الكوفة، لا لأنَّ لأهل الكوفة حجّة باقية عليه في الواقع، بل لأنَّه لم يشأ أن يدع أيَّ مجالٍ لإمكان القول بأنّه لم يفِ تماماً بالعهد، وذلك لو كان قد انصرف عن التوجّه إلى الكوفة في بعض مراحل الطريق.
4 ـ تنفيذ أمر رسول الله’:
وفي مجموعة من النصوص تصريحات من الإمام الحسين× بصدد علّة اختياره التوجه إلى العراق لا إلى غيره، هناك مجموعة من هذه النصوص يُصرّح فيها الإمام× بأنّه إنّما يخرج إلى العراق امتثالاً لأمر رسول الله’.
وقد تلقّى الإمام الحسين× أمر رسول الله’ عن طريق (الرؤيا) التي تكرّرت غير مرةٍ، وهي رؤيا حقّة؛ لأنَّ الرائي إمامٌ معصومٌ× لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ولأنَّ المرئي هو رسول الله’، والثابت في الأثر أنَّ مَن رآه في المنام فقد رآه[120].
فقصد الإمام الحسين× العراق خارجاً من مكّة: تنفيذاً لأمر رسول الله’، وتحقيقاً لأهدافه الناتجة عن شهادته×.
ثمّ إنَّ الإمامَ× خرج بصورة علنيّة، ولم يكن خروجه سرّاً، لكن قد اختار الإمام وقت السحر، لا لكونه يريد الخروج مستتراً خوفاً من مواجهة حربيّة علنيّة مع السّلطة الأُموية في مكة، وإنّما لأجل ما تحمله نفسه الشّريفة من غيرةٍ حسينيةٍ هاشميةٍ تأبى أن تتصفّح أنظارُ النّاس في مكّة حرائرَ بيت العصمة والرسالة والنساء الأُخريات في الركب الحسيني في حال خروج الإمام× في وضح النهار، حيث تغصّ مكّة بالناس.
إنّ هذا الأمر هو السّبب الأقوى من بين تلك الأسباب الّتي دفعت الإمام× إلى الخروج في السحر، أو في أوائل الصبح[121]، خرجوا بذاك العزّ الشامخ، التفتَ الإمام الحسين لأصحابه، وقال: «مَن منكم يعرف الطّريق على غير الجادّة؟» فقال الطّرمّاح: أنا يا بن رسول الله’. فقال له الإمام: «تقدّم أمامَ الركب» فتقدّم وجعل يرتجز ويقول:
|
يا ناقتي لا تذعري من زجري |
حتّى وصلوا كربلاء ونزلوا بها، ولسان حال العقيلة زينب‘:
|
طلعنه بشملّنه امن المدينة |
(أبو ذية)
نزل وبكربله خيامه نصبها
ولعد الموت راياته نصبها
عليه امقدّر إمن الله نصبها
مصارعهم بهل التربة الزكية
***
|
الله أكبر ما أجلَّ رزيةً |
المحاضرة السابعة: من مواعظ سيد الشهداء ×
|
|
أأسبلتَ دمعَ العينِ بالعبراتِ وبتَّ تُقاسي شِدةَ الزّفراتِ |
|
|
يجدي عزيزكم منحور نحرَه |
|
|
***
من كلمةٍ لإمامِنا الحسين× أنّه قال: «لا تطلب مِن الجزاء إلّا بِقدرِ ما صنعت، ولا تفرحْ إلّا بما نِلت من طاعةِ الله، ولا تتناول إلّا ما رأيت نفسَك له أهلاً»[124].
هذه الكلمات هي مقطع من كلمة قصيرة لإمامنا سيّد الشُّهداء× ينهى فيها عن ثلاث أُمُور:
الأمر الأول: لا تطلب من الجزاء إلّا بقدر ما صنعت.
والأمر الثاني: لا تفرح إلّا بما نِلت من طاعةِ الله.
والأمر الثالث: لا تتناول إلّا ما رأيتَ نفسك له أهلاً.
أمّا الأمر الأول: فالإمام× ينهى المؤمنين فيه أن يطلبوا من الجزاء أكثر ممّا صنعوا؛ لأنَّ الإنسان إذا طلب من الجزاء أكثر ممّا صنع ـ سواء كان مع الله سبحانه وتعالى أم مع الإنسان المؤمن الآخر ـ فسيكون قد رضى عن نفسه أكثر من المطلوب، ولازم هذه الحال العُجب غالباً، وقد نهى رسول الله| عن العُجب وحذّر منه أشدَّ التحذير، حتّى روي عنه أنّه قال: «لو لم تُذنبوا لخشيتُ عليكم ما هو أكبرُ من ذلك، العُجب العُجب»[125]، فالعُجب مبطِل للأعمال، حتّى رُويَ عن مولانا الصّادق× أنّه قال: «أتى عالمٌ عابداً فقال له: كيفَ صلاتُك؟ فقال: مثلي يُسألُ عن صلاته، وأنا أعبُد الله منذ كذا وكذا. فقال: فكيف بكاؤك؟ قال: أبكي حتّى تجري دموعي.
فقال له العالم: فإنَّ ضحكَكَ وأنت خائف أفضل من بكائك وأنت مُدلٌّ، إنّ المُدلَّ لا يصعد مِن عمله شيء»[126].
وقال×: «إنّ عيسى بن مريم× كان من شرائعه السيح في البلاد، فخرج في بعض سيحه ومعه رجل من أصحابه قصير، وكان كثيرَ اللُزوم لعيسى×، فلمّا انتهى عيسى إلى البحر قال: بِسم الله بصحّةِ يقينٍ مِنه. فمشى على ظهر الماء، فقال الرجل القصير ـ حين نظر إلى عيسى جازه ـ: بسمِ الله، بصحّةِ يقينٍ مِنه، فمشى على الماء ولحِقَ بعيسى×، فدخله العُجب بنفسه، فقال: هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي فما فضله عليّ؟! قال: فرَمسَ في الماء، فاستعانَ بعيسى× فتناوله من الماء فأخرجه، ثُمَّ قال له: ما قُلتَ يا قصير؟ قال: قُلت هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي، فدخلني من ذلك عُجب، فقال له عيسى: لقد وضعتَ نفَسك في غير الموضع الّذي وضعك الله، فمقتك الله على ما قُلت، فتُب إلى الله} ممّا قُلتَ.
قال: فتاب الرَّجُل، وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله فيها»[127].
ولا يطلب من الجزاء أكثر ممّا يستحق؛ لأنّنا لا نستحق على الله شيء، يعني مجرد أنّ الإنسان وُفّقَ لطاعة من الطّاعات لا يرى أنّه استحقّ على الله الجزاء الأوفر؛ لأنّه بتوفيق من الله، فكلّ عمل نعمله في طاعة الله} لله تبارك وتعالى أعلى مراتب الشكر فيه؛ ولذلك يقول الإمام زينُ العابدين×: «فأشْكَرُ عبادِك عاجزٌ عن شُكرِكَ»[128].
أمّا الأمر الثاني: فالإمام× ينهى المؤمنين فيه أن يفرحوا بالأُمور الّتي ينالونها في غير طاعة الله، يعني الفرح له قسمان: فرحٌ في طاعة الله، وفرحٌ في غير طاعة الله، فالإمام يقول: «ولا تفرح إلّا بما نلتَ من طاعة الله»، يعني: يحصر الفرح بما كان في طاعة الله.
فالإنسان تارةً يفرح؛ لأنّه نال طاعة من طاعات الله، وهي بعدد أنفاس الخلائق، فهذا التوفيق لحضور مجلس تعزية على سيد الشهداء× من أهمّ الطّاعات لله سبحانه وتعالى، التوفيق لزيارة مراقد الأئمّة وأولادهم^ طاعة، ففرح المؤمن بهذه الطاعات مطلوب، وإلّا فلا فرح حقيقي إذا لم يقترن بطاعة الله سبحانه وتعالى؛ ولذا يدخل رجُل على الإمام أمير المؤمنين× في يوم العيد، فيقول له×: «إنّما هو عيدٌ لمن قَبِل الله من صيامه، وشكر قيامه، وكلّ يومٍ لا يُعصى الله فيه فهو عيد»[129]، يريد أن يبيِّن الإمام× أنّ حقيقة العيد ومناط الفرح فيه هو طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم معصيته، لا أن يفرح الإنسان لأنّه تحقّق له مالٌ أو سكن أو عمل، نعم، هي أُمور جيّدة لكن بهذا القيد (طاعةُ الله سبحانه وتعالى)، وإلّا فهي بنفسها لا فائدة منها، بل قد تكون وبالاً على الناس المالكين لها؛ لأنَّ هذه الأُمور مشتركة بين الطاعة وبين المعصية، وكلّ شيء من هذا القبيل قابل أن يكون فيه لله رضا، ويَمكن أن يكون فيه سخط، ولذا يقول الإمام أميرُ المؤمنين×: «المؤمن يُكتب مُحسناً ما دام ساكتاً، فإذا تكلّم كُتب مُحسناً أو مسيئاً»[130].
الكلام هو كلام واحد، لكن يشترك بين رضا الله وبين سخطه، فقراءة الكتاب المفيد فيها أجرٌ وثواب كما إذا احتوى على فضائل أهل البيت^، وقراءة الكتاب المنحرف فيها إثم وعقاب، والقراءة واحدة، وماشاء الله من هذهِ المصاديق العديدة، والإمام الحسين× في هذا المقطع يريد أن يقول: اجعل فرحَك بقدر ما نِلت من طاعة الله؛ لأنَّ المؤمن هو مَن سرّتهُ الحسنةُ وأسائته السيئة[131]، فإذا أتى بطاعةٍ من طاعات الله سبحانه وتعالى وفرح بها لأنّه وُفّقَ لها لم يكن مأثوماً، لأنّه ليس بعُجب؛ إذ هناك فرق كبير بين الفرح بطاعة الله ـ الّذي هو المطلوب ـ والعُجب المنهيّ عنه، فالفرح هو أنَّك ترى لله عليك الفضل والامتنان في توفيقك لهذا العمل، وأنَّك مازلت مُقصّراً كُلَّ التقصير أمام الله سبحانه وتعالى، ولا ترى لنفسك شيئاً، والتوفيق كُلّه من الله سبحانه وتعالى.
أمّا العُجب فترى أنّك قد حققّتَ الطّاعة القُصوى لله، ولا ترى أحداً أتى بما أتيتَ به، وكانَّك الأوحدي في عبادتك لله، وهذه من وساوس الشّيطان.
مثلاً: يوفّق الإنسان لصلاة الليل، فإذا أقامها في السّحر، ثمّ بعد ذلك ألحقها بخشوعٍ ومُناجاةٍ ودموعٍ ولا أحد يدري به إلّا الله سبحانه وتعالى، في صباح ذلك اليوم يمشي على أطراف أصابعه أنّه وُفّق لهذه الطاعة، فماذا يريد الله منه؟! ومَن مثلُه قد فعل ذلك؟! وأقرانه قد تفوتهم صلاة الفجر وهو في السّحر مع الله وحده، لا يعلم به أقرب المقرّبين إليه، هذا هو الخطر الفضيع للمؤمن وهو من مزالق الشيطان الخطرة جدّاً.
الأمرُ الثالث: «ولا تتناول إلّا ما رأيتَ نفَسك له أهلاً»، يعني: إشارة خفيفة إلى قول الإمام أمير المؤمنين×: «رَحِمَ الله امرءاً عرف قدره ولم يتعدَّ طوره»[132]، أي: لا تطلب إلّا ما يُناسبُك وما هو أهل لك وأنت أهل له، وإلّا فتجلب لنفسك العار والشّنار في الحياة الدنيا، والعقوبة في الآخرة، ولذلك يُروى أنّ بهلولاً أتى يوماً إلى قصر الرشيد فرأى المسند والمُتكأ الّذي هو مكان هارون خالياً، فجلس في مكانه لحظةً، فرآه الخدم والحجّاب، فضربوه وسحبوه من مكان الخليفة، فلمّا خرج هارون من داخل القصر رأى بهلولاً جالساً يبكي، فسأل الخدم، فقالوا: جلس في مكانك فضربناه وسحبناه، فزجرهم وعنّفهم، وقال له: لا تبكِ. فقال: يا هارون، ما أبكي على حالي، ولكن أبكي على حالك، أنا جلستُ في مكانِك هذهِ اللحظة الواحدة فضربوني هذا الضرب الشّديد، وأنت جالس في هذا المكان طول عمرك فكيف يكون حالك غداً؟![133] يعني: هذا المكان ينبغي أن يجلس فيه مَن يعدل في الرعية وينصف في القضية، ويَقضي بالسوية، وأنت لست بأهلٍ؛ لأنّ هارون السفيه لم يعرف قدره حقّ معرفته، وأعطى نفسه ما لا تستحقّ، وتناول ما لم يكن له أهل، وكانت الأحقيّة لإمامنا المظلوم المسموم الإمام الكاظم×، فعلى الإنسان أن يضع نفسه في الموضع الّذي هو أهل له، وإلّا فالويل له.
ولهذا نرى أنَّ إمامنا الحسين× رأى نفسه أهلاً لقيادة الأُمّة من الراعي يزيد، فعندما هلك مُعاوية، وذلك في رجب سنة ستين للهجرة كتب يزيد بن مُعاوية إلى الوليد بن عُتبة بن أبي سفيان بن حرب الأُموي ـ وقد وُلّي المدينة سنة (57) للهجرة أيام مُعاوية ـ يأمرُه بأخذ البيعة له من أهلها عامّة، ومن الحُسين بن علي× خاصّة، ويقول له: إن أبى عليك فاضرب عُنقَه وابعث إليّ برأسه.
فأحضر الوليد مروانَ بن الحكم واستشاره في أمر الحسين×، فقال: إنّه لا يقبل، ولو كنت مكانك لضربتُ عنقَه، فقال الوليد: ليتني لم أكُ شيئاً مذكوراً. ثمّ بعث إلى الإمام الحسين× فجاءه في ثلاثين رجلاً من أهل بيتهِ ومواليه، فنعى الوليدُ إليه مُعاوية، وعرض عليه البيعة ليزيد، فقال الإمام الحسين×: «أيّها الأمير إنّ البيعة لا تكون سرّاً، ولكن إذا دعوت الناس غداً فادعُنا معهم»، فقال مروان: لا تقبل أيُّها الأمير عذره، ومتى لم يُبايع فاضرب عُنقه.
فغضب الإمام الحسين× ثمّ قال: «ويلي عليك يابن الزرقاء، أنت تأمر بضرب عُنقي، كذبتَ والله ولؤمتَ» ثمَّ أقبل على الوليد، فقال: «أيّها الأمير إنّا أهلُ بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومُختلف الملائكة، وبنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجلٌ فاسقٌ شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، (ليس له هذه المنزلة، يعني: أنّه ليس أهلاً لهذا المكان) ومثلي لا يبايع مثله، (الإمام× لم يقُل وأنا لا أبايعُ يزيد، بل يقول: الّذي هو مثلي في الأهداف والمبدأ لا يبايع الّذي يحمل ما يحمله يزيد إلى يوم القيامة، غير مختصٍ في زمانٍ أو مكانٍ مُحدّد) ولكن نَصبح وتصبحون، وننظُر وتنظرون أيَنا أحقَّ بالخلافة والبيعة»[134]، وبالفعل فإنّ الإمام الحسين× انتظر ذلك اليوم الّذي رفع فيه شعار لا إله إلّا الله، وهيهات منّا الذلة، ولكنَّها كلمة احتاجت دِماء تفديها لئلّا تخمد، فقدّم القُربان تُلو القربان، والعزيزَ تُلو العزيز إلى أن وصل الأمرُ إليه فشاء الله أن يراه قتيلاً.
يقول الراوي: والله لا أنسى زينبَ بنتَ عليٍّ وهي تندب أخاها الحسين، وتنادي بصوتٍ حزينٍ وقلبٍ كئيبٍ: «يا مُحمّداه، يا رسولَ الله، صلّى عليك مَليكُ السمآء، هذا حُسينُك مُرمَّل بالدماء، مقطّعُ الأعضاء، وبناتكَ سبايا، إلى الله المشتكى وإلى مُحّمدٍ المصُطفى وإلى عليِّ المرتضى وإلى فاطمةَ الزهراء وإلى حمزةَ سيّد الشُهداء، يا مُحّمداه، هذا حسين بالعراء، تسفي عليه ريحُ الصَّبا، وا حُزناه، وا كرباه عليك يا أبا عبد الله، اليوم مات جدّي رسولُ الله|»[135].
ولسان حال سيّد الشّهداء× لأخته زينب‘:
|
خويه هالترابة أحرگت
خدّي خويه والعطش ذوبه الچبدي |
صورة لزينب‘ عندما نظرت فرأت أخاها الحسين× على وجه الأرض يقَبضُ يميناً ويبسطُ شِمالاً، والدم يسيل من جراحاته كالميزاب، فرمت بنفسها على جسده الشريف:
هوت فوگه تصيح ابصوت يحسين
عليك أُمّك يخويه ديرلي العين
ونّ وصاح يا زينب اشتردين
كـسرت الگلب مِنّي وزدتي الهمّ
ردّي الخيمتچ لمي أطفالي
اوعگب عيناي عينچ على اعيالي
يخويه الشمر هالموچب اگبالي
دشوفيه على چتلي إشلون مهتمّ
يخويه بيش أضمّك وين أوديك
يخويه اشلون أصد عنك وخليك
تراني اتحيّرت يا مهجتي بيك
يخويه بيش أضللك عن الحرّ
***
|
قُتل الحُسين فيا لها من نكبةٍ عمّتْ قُلوبَ المؤمنينَ جميعاً |
المحاضرة الثامنة: فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
رَحلوا وما رحَلوا أُهيلُ ودادي |
(نصّاري)
|
سار احسين وأمسه الحرم مِغبِر يويلي والمدينة صُفَتْ تِصفِر |
***
قال الله تعالى في مُحكم كتابه الكريم: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[137].
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروع الدّين الّتي لا تقلّ أهميّة عن غيرها من الفروع كالصلاة وغيرها، وقد حثَّ الله سبحانه وتعالى على هذهِ الفريضة العظيمة في آيات عديدة، منها هذهِ الآية وآيات أُخرى، مثل قوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾[138] إلى غير ذلك من الآيات القرآنية المباركة.
وقد أكّد النبيُّ’ على هذه الفريضة العظيمة في أكثر من حديث، فقد قال’: «لا يزال الناسُ بخيرٍ ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر...»[139].
وكذلك قال أميرُ المؤمنين×: «مَن ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميّت بين الأحياء»[140].
وكذلك قد حثَّ الأئمّة^ على هذه الفريضة، ومن بعد الأئمّة جاء دور ممثّلي الأئمّة، ألا وهم الفقهاء، فقد اهتمّوا بهذه الفريضة اهتماماً بالغاً، وعقدوا لها باباً خاصّاً في كتبهم، واستدلّوا على وجوبها بالنصّ القطعي من القرآن الكريم والرّوايات الشريفة، وبإجماع المسلمين، وضرورة الدّين، تماماً كالصّلاة والصّوم، بل قال بعضُ فُقهائنا: إنَّ وجوبَه ثابتٌ بالعقل، لا بالسمع، وأنَّ النصّ الثابت في الكتاب يرشدُ إلى حكم العقل ويؤكّده، بحيث نحكم بالوجوب، حتى ولو لم يرد نصٌّ بِه من الشّارع.
نعم، اختلف الفقهاء في أنّه هل يجب عيناً، بمعنى: أنّه كالصّلاة اليومية لا بُدَّ على كلّ إنسان أن يأتي به؟ أو كفايةً، بمعنى: أنّه يسقط عن الجميع بفعل البعض كالصّلاة على الميت؟ ذهب بعضُ الفقهاء إلى الأوّل وبعضٌ إلى الثاني[141].
ومنشأ اختلافهم ـ في أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هما واجبان عيناً أو كفاية ـ في تفسير (مِن) في الآية المذكورة في صدر الكلام، فمنهم مَن قال إنّها تبعيضية، أي: ولتكن منكم بعض الأُمّة؛ لأنّ الإنسان عندما يقول ـ مثلاً ـ: قرأتُ من الكتاب، فيعني أنه قرأ بعض الكتاب؛ ولذا ذهب البعض إلى أنّه واجب كفائي. أمّا البعض الآخر فيرى أنّ (من) هنا بيانية وليست تبعيضية[142].
وعلى أيّة حال فالآية المُباركة اشتملت على ثلاثة أُمور نُكلَّف بها، أولها: الدعوة إلى الخير، ثُمَّ الأمر بالمعروف، ثُمَّ النهي عن المنكر، ولأجل العطف الموجود بين هذه الثلاثة يجب كون هذه الثلاثة متغايرة، فالدّعوة إلى الخير جنس تحته نوعان:
أحدهما: الترغيب في فعل ما ينبغي فعلُه، وهو الأمر بالمعروف.
وثانيهما: الترغيب في ترك ما لا ينبغي فعلُه، وهي النهي عن المُنكر، فذَكر الجنس أوّلاً، ثُمَّ اتَبعه بنوعيهِ مُبالغةً في البيان[143].
والدعوة إلى الخير لا تنحصر في أمرٍ من الأُمور، بل هي تشمل كلّ ما فيه لله رضىً، إنسان يُوصي إنساناً آخر لحضور مجالس العزاء، فيها دعوة للخير وأمر بالمعروف وإن كان مُستحبّاً؛ لأنّ الأمر بالمعروف إذا وقع على شيء مستحبّ يكون الأمر به حينئذٍ مُستحبّاً، وإن وقع على شيء واجب يكون الأمر حينئذٍ واجباً.
فالآية تُشير إلى أنَّ الأُمّة من أُمّةِ مُحّمدٍ’ كما قال الإمام الصّادق×: في ذيل هذه الآية: «لأنّه مَن لم يكن يدعو إلى الخيرات ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من المسلمين فليس من الأُمّة الّتي وصفها؛ لأنّكم تزعمون أنَّ جميعَ المُسلمين من أُمّةِ مُحمّدٍ’ قد بدت هذه الآية وقد وصفت أمّة محمّدٍ’ بالدُعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومَن لم يُوجد فيه الصفة الّتي وصِّفت بها فكيف يكون من الأُمّةِ وهو على خلاف ما شرطه الله على الأُمّة ووصّفها به؟!»[144].
ومن بعد معرفة أهمّية هذه الفريضة لا بُدَّ من التحدُّث عن شرائطها؛ لأنَّ كُلَّ فريضةٍ من الفرائض لا بُدّ لها من شروط، وهذه الفريضة هي كباقي الفرائض لا تقلّ أهميّةٍ عنها، ولها أيضاً شروط لا بُدّ من معرفتها واجتماعها حتّى تجب، سواء كانت وجوباً عينيّاً أم كفائيّاً، وهذه الشروط هي:
1 ـ معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً، فلا يجبان على الجاهل بالمعروف والمُنكر.
2 ـ احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي، فإذا لم يُحتمل ذلك، وعَلِمَ أنّ الشّخص الفاعل لا يُبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بِهما لايجب عليه شيء.
3 ـ أن يكون الفاعل مُصرّاً على ترك المعروف وإرتكاب المُنكر، فإذا كانت أمارة على الإقلاع، وترك الإصرار لم يجب شيء.
4 ـ أن يكون الفاعل عالماً بالمعروف والمُنكر، فإن كان معذوراً في فِعله المُنكر أو تركه المعروف ـ لاعتقاد أنَّ ما فعله مُباحٌ وليس بحرام، أو أنَّ ما تركه ليس بواجب، أو كان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم، اجتهاداً أو تقليداً ـ لم يجب شيء[145].
5 ـ أن لا يلزم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس، أو في العِرض، أو في المال على الآمر أو على غيره من المُسلمين، فإذا لزم الضّرر عليه، أو على غيره من المسلمين لم يجب شيء، ولا بُدّ في هذا الشّرط من ملاحظة الأهمّ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتّب الضّرر أيضاً إذا كان الأمر هو الأهمّ من تحمّل الضّرر، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. فإذا اجتمعت هذهِ الشّروط الخمسة يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر.
ثمّ للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر مراتب هي:
الأُولى: الإنكار بالقلب، بمعنى إظهار كراهة المُنكِر، أو ترك المعروف، إمّا بإظهار الإنزعاج من الفاعل، أو الإعراض والصدّ عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعلٍ، أو تركٍ يدلّ على كراهة ما وقع فيه.
الثانية: الإنكار باللسان والقول، بأن يعظه، وينصحه، ويذكر له ما أعدَّ الله سُبحانه للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعدّه الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنّات النعيم.
الثالثة: الإنكار باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية.
ولكلِّ واحدة من هذه المراتب الثلاث مراتب أخفّ وأشدَّ، والمشهور الترتّب بين هذه المراتب، فإنْ كان إظهار الإنكار القلبي كافياً في الزجر اقتُصر عليه، وإلّا أنكر باللسان، فإنْ لم يكن يكفي ذلك أنكره بيده، مراعياً الترتيب المأخوذ في هذه المرتبة الثالثة شيئاً فشيئاً[146].
ولذلك رأى أبو عبد الله الحسين× أنْ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بدعوته إلى الخير، وبيّن ذلك بوصيته إلى أخيه مُحّمد بن الحنفية: «إنّي لم أخرُجٍْ أشِرَاً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجتُ لطلبِ الإصلاح في أُمّةِ جدّيَ مُحّمد’، أُريدُ أن آمرَ بالمعروف وانهى عن المُنكر، وأسير بسيرة جدّي محمّد’ وأبي عليِّ بن أبي طالب×، فمَن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومَن ردّ عليّ هذا أصبرُ حتّى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خيرُ الحاكمين...»[147].
روى عبد الله بن سُليم ـ وغيره ـ قال: كُنّا نسير مع الإمام الحسين× حتّى نزل شِراف، ولمّا كان السّحر أَمرَ أصحابَه أن يحملوا الماء وأن يكثروا، فلّما أصبحوا ساروا من شراف حتّى انتصف النهار، بينما هُم يسيرون إذ كبّر رجل من أصحابه، فقال له الإمام الحُسين×: «الله اكبر، لِمَ كبّرت؟» قال: سيّدي رأيتُ النخلَ. فقال له رجل من أصحابه: ما رأينا في هذا المكان نخلةً واحدةً. فقال الحُسين×: «وما ترون؟» قالوا: والله، لا نرى إلّا أسنّةَ الرّماح وآذان الخيل. فقال×: «وأنا والله أرى ذلك»، ثُمَّ قالَ×: «ما لنا ملجأ نلجيء إليه ونجعله خلفَ ظُهورِنا ونستقبل القوم بوجهٍ واحد؟» قالوا: بلى، هذا ذو حُسمٍ إلى جنبك، فمل إليه عن يسارك. فأخذ ذات اليسار.
قال: فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل، كأنّ أسنتهم اليعاسيب، وكأنّ راياتهم أجنحة الطّير، فأمر الإمام الحُسين× بالأبنيةِ فضُربت، وجاء القوم زهاءَ ألف فارسٍ، يتقدّمهم الحُرّ بن يزيد الرياحي وكان مجيئه من القادسية، فنزل حِذاء الإمام الحُسين× في حرّ الظهيرة، والإمام الحُسين وأصحابه جالسين مُتقلدي أسيافهم.
فقال الإمام الحسين× لفتيانه: «اسقوا القوم وارووهم من الماء، ورشّفوا الخيلَ ترشيفاً» فأقبلوا يملئون القصاع والطساس، ثمّ يُدنونها من الفرس حتّى أسقوهم عن آخرهم.
قال الراوي: وما زال الحُرّ مخالفاً للحسين× حتّى حضر وقت صلاة الظهر فأمر الحسين× بالأذان، فأُذن، ثُمَّ خرج الإمام الحسين× والتفت إلى الحُرّ، وقال: «أتُصلي بأصحابك؟»
فقال الحرّ: كلّا، بل تُصلّي ونُصلي بصلاتِك، فصلّى الإمام الحُسين× فلمّا فرغَ من صلاته أقبل عليه بوجهه، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه، وذكر النبيَّ فصلّى عليه، ثُمَّ قال: «أيُّها الناس، إنّي لم آتِكم حتّى أتتني كُتبُكم، وقَدمتْ عليَّ رُسُلُكم، فإن كنتم لقُدومي كارهين انصرفتُ عنكم إلى المكان الّذي جئتُ منه».
فقال الحرّ: أنا والله، لا أدري ما هذه الكتب والرُسل! فصاح الإمام الحسين× لعقبة بن سمعان: اُخرُج الخرجين المملوئين صُحفاً. فأخرجها عقبة ونشرها بين يديّ الحُسين× والحرّ، فقال الحرّ: لستُ من هؤلاء الّذين كتبوا إليك، وقد أُمرتُ أن لا أفارقك حتّى أُدخلَك الكوفة ولأضع يدك في يد ابن زياد.
فقال الإمام الحسين×: «إذاً الموت أدنى إليك من ذلك»، فحال الحرّ بينهم وبين المسير.
فقال الإمام الحسين×: «ثكلَتك أُمُّك ماذا تريد منهم؟» فقال الحرّ: لو غيرُك من العرب قالها لي، وهو على هذا الحال الّذي أنت عليه ما تركتُ ذكر أُمّه بالثّكل كائناً مَن كان، ولكن والله، ما لي إلى ذكر أُمّكَ من سبيل إلّا بأحسن ما نقدرُ عليه.
فقال الإمام الحسين×: «إذن ماذا تريد؟» قال: أُريدُ أن أنطلق بك إلى الكوفة، إلى ابن زياد.
فقال الإمام الحسين×: «إذن والله، لا أتّبعك». فقال الحرّ: إذن والله، لا أدعُك. فترادّا القول في ما بينهم ثلاث مرّات، فخشي الحرّ الفتنة، فقال: يا أبا عبد الله، إنّي أُمرتُ إذا لقيتُك لا أفارقُك، فإذا كان الأمر كذلك فخذ طريقاً لا يردُّكَ إلى المدينة ولا يدخلك الكوفة؛ ليكون بيني وبينك نصفاً، حتّى أكتُبَ إلى ابن زياد، لعلَّ الله أن يأتي بأمرٍ يرزقني فيه العافية من أن آتي بشيء من أمرك، فخذ ها هنا تياسُراً من طريق العذيب والقادسية. فرضي الإمام الحسين× بذلك، فساروا، فبينما هم يسيرون التفتَّ الحُرّ إلى الإمام الحسين× وقال له: يا أبا عبد الله، إنّي أُذكّرُكَ الله في نفسِك، فإنّي أشهدُ لإن قاتلتَ لَتُقتَلَنَّ، فقال له الإمام الحسين×: «أفبالموت تخوّفني؟! وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقول كما قال أخو الأوس لإبن عمّهِ، وهو يريد نصرة الرّسول فخوّفه ابنُ عمّه وقال له: أين تذهب؟! إنّك مقتول. فأنشأ يقول:
|
أُقدّمُ
نفسـي لا أُريدُ بقاءَها |
قال: فلمّا رأى امتناعَ الحُسين× سكت وجعل يُسايره، فلمّا أصبح الصّباح نزل وصلّى، ثُمَّ عجّل بالركوب، فأخذ يتياسر بأصحابه يُريدُ أن يُفّرقهم حتّى انتهوا إلى نينوى[148]. ويُروى أنَّ الإمام الحُسين× قال لأصحابه: «مَن مِنكم يعرف الطريق؟» فقال الطّرمّاح[149]: أنا يا ابن رسول الله، فقال له الحُسين×: «تقدّم»، فتقدّمَ الطّرمّاح أمام الركب، وجعل يرتجز ويقول:
|
يا ناقتي لا تذعري من زجريِ واسرِ بنا قبلَ طُلوعِ الفجرِ[150] |
فسارت ضعينة الإمام الحسين× على هذه الحالة، وقد حفّتها بنو هاشم وأصحابُه الصّفوة والطّرمّاح يحدو بِها، ولكنَّها يوم خرجت من كربلا حفّت بها الأعداء من كلِّ جانب، وسارتْ على حالةٍ يحدو بها شمرُ بن ذي الجوشن وزجر بن قيس:
|
أيسوقُها زجرٌ بضـربِ مُتونِها والشّمرُ يحدوها بسبِّ أبيِها |
وزينب تخاطب أخاها بلسان الحال:
|
ودّعتك الله يا عُيوني يردون عَنك ياخذوني |
گـطعت الرّجه اوخابـت اظنوني
وكأنيّ بِها توجّهت إلى جِهة العلقمي، وخاطبت الجمّال أيّامَ رجوعِها من السّبي:
|
يجمّال مُرّ بينا اعلى عباس اخونه العجيد اليرفع الراس |
تتفرج على أحوالنا النّاس
***
|
هذه زينبُ ومن قَبلُ كانت بحمى دارها تُحطُّ الرحالُ |
المحاضرة التاسعة: أقسام العبادة
ولقد وقفتُ فما وقفنَ مَدامعي |
(فائزي)
طوّح الحادي والظعن هاج ابحنينه
اوزينب تنادي سفرة الگـشرة علينه
صاحت ابكافلها شديد العزم والباس
شمّر اردانك وانشـر البيرغ يعباس
چني أعاينها مُصيبة اتشيّب الراس
ما ظنّتي نرجع ابجمعتنه المدينة
گلها يزينب هاج عزي لا تنخّين
ما دام أنه موجود يختي ما تذلّين
***
(أبو ذية)
|
يناعي حيل صيح بصوت وليان |
***
رُويَ عن الإمامِ الحُسين× أنَّه قال: «إنّ قوماً عَبدُوا الله رغبةً فتلك عبادةُ التجّار، وإنَّ قوماً عبدوا الله رهبَةً فتلك عبادةُ العَبيدِ، وإنَّ قوماً عبدوا الله شُكراً فتلك عِبادةُ الأحرارِ وهي أفضلُ العبادةِ»[153].
من عيون الأحاديث والروايات المرويّة عن أهل البيت^ هذا الحديث، وهذهِ الرواية الشّريفة، والّتي ورد مضمونها عن أكثر من إمام معصوم، فقد ورد مضمونها في النهج الشريف عن أمير المؤمنين× ولعلّه نصّها حيث روي عنه× أنّه قال: «إنّ قوماً عبدوا الله رغبةً...»[154] لكن من دون ذكر (وهي أفضل العبادة) ومع تغيير (شكراً) بـ(حبّاً).
وورد عن الإمام الصّادق× أيضاً، لكن جاء فيه: «العباد ثلاثة: قوم عبدوا الله} خوفاً، فتلك عبادة العبيد، وقومٌ عبدوا الله تبارك وتعالى طلباً للثواب، فتلك عبادة الأُجراء، وقومٌ عبدوا الله} حُبّاً له، فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة»[155] وهو يشابه ما في النهج.
والرواية معتبرة ـ كما عبّر بعض المحقّقين عنها ـ أو ضعيفة كما عن بعض آخر[156].
ولعلّها تختلف باختلاف سندها المروي عن المعصوم×، فكما ذكرنا أنّها رُويت عن الإمام أمير المؤمنين× تارة، وعن الإمام الحسين× أُخرى، وعن أبي عبد الله الصّادق× ثالثةً. ويمكن أن تكون مرويّة عن غيرهم^ من الأئمّة^ فكلامهم واحد، كما أنَّ نورهم نور جدّهم المصطفى|.
ولو تأمّلنا في الرواية الشّريفة الّتي صدّرنا بها المجلس نجد أنّ الإمامَ الحُسين× حصر العبادة الّتي يترتّب عليها الثواب والكرامة إجمالاً بثلاثة أقسام، وأمّا غيرها من الأقسام، مثل: عبادة المرائي ونحوها فليست بعبادة حتّى تدخل في المقسم[157].
ثُمَّ إنَّ الملفت للنظر أنَّ التعابير في الروايات الثلاث المتقدّمة، أعني: ما روي عن الإمام الحسين×، وعن الإمامينِ أمير المؤمنين والصّادق‘ عبّرت بالشّكر تارةً وبالحبّ أُخرى بالنسبة لعبادةِ الأحرار والّتي هي أفضل العبادة، فما هو الوجه في هذا الاختلاف؟
والجواب: إنَّ الاختلاف لفظيّ وليس معنويّ حقيقيّ؛ «فإنّ الشّكر وضع الشّيء المُنعَم به في محلّه، والعبادة شكرها أن تكون لله الّذي يستحقّها لذاته، فيعبد الله؛ لأنّه الله، أي: لأنّه مستجمع لجميع صفات الجمال والجلال بذاته، فهو الجميل بذاته المحبوب لذاته، فليس الحُبّ إلّا الميل إلى الجمال والانجذاب نحوه، فقولنا فيه تعالى: هو معبود لأنّه هو، وهو معبود لأنّه جميل محبوب، وهو معبود لأنَّه مشكور بالعبادة، يرجع جميعها إلى معنىً واحد»[158].
ويمكن أن نقسّم العبادة والعبيد المقيمين لها إلى أقسام ثلاثة:
القسم الأول (عبادة التجّار): وهو نفس ما روي بلفظ (عبادة الأُجراء)؛ فإنَّ الأُجراء يعبدون للثواب، كما أنَّ الأجير يعمل للأجر، وهكذا التاجر يعمل للمال. وهذا القسم هو من المراتب الدنيا بالنسبة للأقسام الثلاثة؛ لحصول الضميمة في القُربة له تبارك وتعالى. وأمثلته عديدة في الفقه، كضمّ نيّة الحِمْية إلى الصّوم، أو التبريد إلى الوضوء، والاشتغال بالصّلاة لأجل تقوية البدن وغير ذلك، كما هو مذكور في محلّه، وقد اختلف الفقهاء في ذلك اختلافاً كبيراً، وأنَّه هل تضرُّ الضميمة المباحة مع الضميمة بالتقرُّب إلى الله تعالى؟
ذهب الكثير منهم للقول بالبطلان.
قال الشّيخ البهائي في محكيِّ البحار عنه+: ذهب كثير من عُلماء الخاصّة والعامّة إلى بطلان العبادة إذا قصد بفعلها تحصيل الثواب، أو الخلاص من العقاب، وقالوا: إنَّ هذا القصد مناف للإخلاص الّذي هو إرادة وجه الله وحده، وأنّ مَن قصد ذلك فإنَّه قصد جلب النفع إلى نفسه، ودفع الضرر عنها، لا وجه الله سبحانه، كما أنَّ مَن عظّم شخصاً أو أثنى عليه طمعاً في ماله، أو خوفاً من إهانته لا يُعدّ مخلصاً في ذلك التعظيم والثناء[159].
ويمكن للقائل بالصحّة بأن يستدلّ بدليلين:
الأوّل: بالآيات المباركة الّتي مدحت وحثّت على طلب الثّواب والخوف منه تبارك وتعالى، حيث يقول}: ﴿كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾[160] أي: للرغبة في الثّواب والرهبة من العقاب، وقوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾[161].
والثّاني: نفس الرواية الّتي صدّرنا بها المجلس، حيث عبّرت بأفضليّة عبادة الأحرار على قسيميها، وهذا ما يدلّ على المشاركة والزيادة؛ إذ العبادة على الوجهين لا تخلو من فضل فتكون صحيحة، وهو المطلوب[162].
ويؤيّدُه ما رُويَ عن الإمام الباقر× أيضاً، حيث قال: «مَن بلغه ثوابٌ من الله تعالى على عملٍ فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أُوتيَهُ وإن لم يكن الحديث كما بلغه»[163]، فإنّ التعبير بالالتماس ـ المقصود منه رجاءً للثواب وطمعاً فيه، وأنَّ الله تبارك وتعالى يعطي ذلك العبد مُناه وما أمّله ورجاه ـ لدليلٌ على جوازه وصحّة العبادة المأتي بها.
القسم الثاني (عبادة العبيد): وهي العبادة الناشئة من خوف الله تبارك وتعالى تشبيهاً لصاحبها بالعبد الّذي يطيع مولاه لا لأجل شيء، بل لكونه خائفاً ومرهوباً منه، فعبادة العبيد الحقيقيّين مع المولى} إذا كانت لأجل التخلّص من النار والعذاب الّذي ينتظر العاصي له تبارك وتعالى، فهكذا عبادة تُسمّى عبادة العبيد، وهي مع الأُولى ليستا من العبادات الّتي فيها تمام الفضل والكمال.
ولعلّ العبادة بهذه الأقسام الثلاثة تختلف باختلاف نفس العباد، فبعضهم يعبد الله تبارك وتعالى لأجل الثواب فقط، كمَن يتقرّب بالنوافل مثلاً. وبعضهم للتخلّص من العقاب وما سيتبعه من ثواب الطاعة، كما هو حال الكثير من بني آدم الّذين يمتثلون الصّلاة والصّوم لا لأجل الثواب، بل خوفاً من استحقاق العقاب، والبعض الثالث يعبدون الله تبارك وتعالى لا لأجل طلب الثواب ولا لخوف العقاب، وإنّما هو الشّوق الإلهي الّذي حدا بهم نحوه تبارك وتعالى، والحبّ الّذي أخذ بقلوبهم، كما رُوي ذلك عن أمير المؤمنين× حيثُ يقول في بعض مناجاته: «ما عبدتُك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنّتك، لكن وجدتُك أهلاً للعبادة فعبدتُك»[164].
وهي من أرفع الدرجات والمقامات، وهي القسم الثالث في الحديث الّذي صدّرنا به الكلام.
القسم الثالث (عبادة الأحرار): وهي عبادة الله تبارك وتعالى وطاعته له لا لأجل الثواب ولا لخوف العقاب وإنّما حُبّاً له تعالى، وشكراً على ما أنعم به على عبيده.
وقد ضرب لنا في ذلك رسول الله’ المثل الأعلى في عبادته شكراً لله تعالى، فقد حُكي عن الاحتجاج أنّه روى عن أمير المؤمنين× أنّ يهوديّاً قال له: إنَّ داوود× بكى على خطيئته حتّى سارت الجبالُ معه لخوفه. قال له عليٌّ×: «لقد كان كذلك، ومحمّد’ أُعطي ما هو أفضل من هذا!؛ إنَّه كان إذا قام إلى الصّلاة سُمِعَ لصدره أزيزٌ كأزيز المِرجَل على الأثافي[165] من شدّة البكاء، وقد آمنه الله} من عقابه فأراد أن يتخشّع لربِّه ببكائه، ويكون إماماً لمَن اقتدى به، وقد قام’ عشرَ سنينَ على أطراف أصابعه حتّى تورّمت قدماه واصفرَّ وجهُه، يقوم اللّيل أجمع حتّى عُوتب في ذلك، فقال الله: ﴿طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾[166] بل لتسعدَ به، ولقد كان يبكي حتّى يُغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله، أليس الله} قد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟ قال: بلى، أفلا أكونُ عبداً شكوراً؟»[167].
فكانت عبادته’ وعبادة أهل بيته^ الغالب فيها الشكر والحبّ للباري}، فالعلاقة بينهم^ وبين خالقهم علاقة المودّة والولاء.
والداعي لعبادة الشّاكرين هو وجود النعم الكثيرة من الخالق الكريم، حيث خلقَ كُلَّ شيءٍ للإنسان من دون أن يحتاج منه إلى شيء إلّا شكره وطاعته.
ومن هنا ورد عن الإمام الرضا× أنّه قال: «... ولو لم يخوّف الله الناسَ بجنّةٍ ونارٍ لكان الواجب عليهم أن يُطيعوه ولا يعصوه؛ لتفضّله عليهم، وإحسانه إليهم»[168].
فعبادة الشّاكرين والمحبّين ـ والّتي هي أفضل الأقسام الثلاثة ـ تجعل العابد ليس له غاية إلّا رضا المحبوب، فكلّ همّه هو إرضاء مَن يُحبّ ولو جرى عليه ما جرى من أنواع البلاء والعذاب، فقلبه متوجّه إلى الحبيب ولا يريد شيئاً منه سوى أن يكون راضياً عنه.
وبهذه العبادة يصير الإنسان أعبد أهل الأرض، كما روي ذلك عن نبي الله يونس (على نبينا وآله وعليه السّلام) أنَّه قال لجبرائيل×: «دلّني على أعبد أهل الأرض» فدلّه على رَجُلٍ قد قطع الجذام يديه ورجليه وذهب ببصره وسمعه، وهو يقول: «إلهي متّعتني بها ما شئت، وسلبتني ما شئت، وأبقيت لي فيك الأمل، يا برُّ يا وصول»[169].
لأنَّ ذلك كان في الله فهان عليه الخطب، وسهل عليه الأمر، وصار أعبد أهل الأرض على حدّ تعبير الخبر.
فكلّ ما يصيب عباد الله تبارك وتعالى يكون من نعم الله عليهم، فهكذا هو ديدن العباد الّذين يعبدون الله تبارك وتعالى حبّاً وشكراً له}.
ولذا لمّا وصل الإمام الحسين× إلى كربلاء وحطَّ رحله الشّريف فيها في أيّام مُحرّم الحرام، وأحاط به الآلاف من أعداء الدّين إلى أن وصل اليوم المحتوم وهو ينظر إليهم، كان يبكي على المصير الّذي ينتظرهم، وفي بعض المنازل الّتي مرّ بها× قال هذه الكلمة: «هوّن ما نزل بي أنّه بعين الله»[170].
أي: أنّ الله تبارك وتعالى يرى بعينه ما يجري علينا ويصيبنا، فَحبّي لله وشكري له يوجب لي أن أُقدّم كُلَّ ما يريده تعالى من طاعة وعبادة.
وعندما سأل مُحمَّدُ بن الحنفية الإمام الحسين× عن سبب خروجه وخروج السّبايا معه، أجاب×: «أتاني رسول الله| بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، اخرج، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلاً»، قال: ما معنى حملك هذه النسوة معك؟ قال: «إنَّ الله قد شاء أن يراهُنَّ سبايا»[171].
ولمّا جاء الملائكة لينصروه لم يأذن لهم، وقال: «نحن أقدر منكم على هلاكهم»، ولم يظهر منه وهنٌ ولا خوف ولا استكانة، بل الّذي ظهر منه× الشدّة في قتالهم، والسّرور بلقاء ربّه، والتشجيع لأصحابه عند لقائهم عدوّهم، وأمرُه لهم بالصّبر هُنيئةً حتّى يشربوا من حوض الرّسول’[172].
وقد كان يقول لأولئك النسوة: «قد شاء الله أن يراني قتيلاً مذبوحاً ظلماً وعدواناً، وقد شاء أن يرى حرمي ونسائي مُشرّدين وأطفالي مذبوحين مأسورين مظلومين مُقيّدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً».
وكأنّي بزينب‘:
وا ذبيحاً من قفاه بالحُسام الباتر
وا طريحاً بعراه ما له من ساتر
وا كسيراً أضلُعاه بصليب الحافر
وا رضيضاً قدماه والطوى والمنكبين
يا أخي قد كُنتَ تاجاً للمعالي والرؤوسِ
مقرياً للضيفِ والسّيف نفيساً ونفوس
كيف أضحى جسمك السامي له الخيل تدوس
بعد ما داست على هام السُّهى بالقدمين
حطَّمَ الحزنُ فؤادي لحطيم في الصّفا
ولهيف القلب صادٍ وذبيحٍ من قفا
ولعادٍ في وهادٍ فوقَه السّافي سفا
صدرَه والظهر فيه أصبحا منخسفين
وبلسان الحال:
|
والله امحيّره ظلّيت يحسين |
(تخميس)
|
أأُخي ذابَ القلبُ من فُرطِ العنا |
||
|
|
قُضيَ القضاءُ بما جرى فاسترجعي |
|
المحاضرة العاشرة: السفير مسلم بن عقيل×
|
حَكَم الإلهُ بما جرى في مُسلمٍ |
ولــه ابـنةٌ مســحَ الحُــسينُ بــرأسها
واليُتم مسحُ الرأس فيه دليلُ[173]
بلى والله، كان يوماً عظيماً على قلوب أهل البيت^، فلمّا بلغهم الخبر عَظُمَ على أبي
عبد الله× المصابُ، واشتدّ به الحُزن، وارتجَّ الموضعُ بالبكاء والعويل، وسالت
الدموعُ عليهِ كُلَّ مسيلٍ، خصُوصاً يتيمتُه حميدة، فانكسر قلبُها، وسالت دموعها،
فأخذها عمُّها الحسين× ووضعها في حجره، وأخذ يمسح على رأسها، عندها استشعرت
باليُتم، وأخذت تبكي والدها.
|
أخذ بت مسلم امن الخيم بيده |
وأخذت تنوح وتبكي والدها، وكأنّي بها:
|
يعمّي اشكثر بيه حلوة الليالي |
(أبو ذية)
|
بت مسلم گضه بوها وملها |
***
من كتابٍ للإمام الحسين× جاء فيه: «من الحُسينِ بنِ عليٍّ إلى الملأ مِنَ المؤمنينَ والمُسلمينَ، فإنِّ هانئاً وسعيداً قدما عليَّ بكُتُبِكُم وكانا آخرَ من قَدِمَ عليَّ من رسُلِكم، وقد فهمتُ كُلَّ الّذي اقتصصتم وذكرتم... وقد بعثت إليكم أخي وابنَ عمّي وثِقتي من أهلِ بيتي وأمرتُه أن يَكتُبَ إليَّ بحالِكم وأمرِكم ورأيِكم..»[174].
لقد جرى الأنبياء والرُّسُل والأوصياء مجرى خالقِهم} في اختيارهم لمَن يُمثّلهم؛ إذ أنّ الله تبارك وتعالى لم يجعل النبوّة والرّسالة والوصاية إلّا في أُناسٍ يراهم هو ـ جلّ وعلا ـ أهلاً لها، ولم يكن هذا الاختيار اعتباطاً منه تعالى وهو الحكيم، وإنّما لكون هؤلاء النفر يُمثّلون مَن بعثهم وأرسلهم واستخلفهم على بنيّ البشر، ولا بدَّ حينئذٍ أن يتمتّعوا بالصّفات اللائقة به}، وهي ما وصف بها نفسَه تبارك وتعالى في القرآن الكريم، من الصفات الجلاليّة والجماليّة.
لذا صار الأنبياء والرُّسل أخلاقهم ما في كتبهم، حتّى رُويَ أنَّ أخلاق رسول الله’ كانت القرآن[175] أي: ما يريدُه الله تبارك وتعالى للإنسان الكامل.
وهكذا جرت السُّنّةُ على اختيار الشّخص المناسب للمكان المناسب. فرسولي ستخلف وصيّاً، ووصيٌّ يستخلفُ وصيّاً آخر أو ممثّلاً عنه، يحكيه أو يحكي بعضَ صفاته.
وهذا ما حدث وصار جليّاً في انتخاب سيّد الشهداء وريحانة المصطفى’ لمسلم بن عقيل، بعد أن أتته كتب أهل الكوفة تتراً، تحثّه على القدوم إليهم، لينقذهم من جور الأُمويين وظلمهم، ورأى الإمام أنَّ الواجب الشَّرعي يدعوه للقيام بهذه المهمّة الخطيرة.
ولكن قبل كلّ شيء رأى من المصلحة أن يختار سفيراً له، يعرّفه بصدق ثبات أهل الكوفة، فإن رأى منهم عزيمةً صادقةً فيأخذ البيعة له منهم، ثمَّ يتوجّه× لهم، فعزم على اختيار البطل الهُمام والشُّجاع المقدام مسلم بن عقيل بن أبي طالب×، وهو من أفذاذ الرّجال، ومن أمهر السّاسة، وأكثر قابليةً على مواجهة الظّروف والصّمود أمام الأحداث[176].
ولذا يقول الشّيخ العلّامة عبد الواحد المظفّر في هذا المجال:
|
تصفّحتُ أخبارَ السفارةِ لم أجد |
والكلمة الغرّاء لسيّد الشُّهداء× ذُكرت بصورٍ متعدّدةٍ وما ذكرناه هنا هو ما رواه المؤرّخ الشهير الطّبري في تاريخه.
ويشتمل هذا النصّ على الأُمور التالية:
الأمر الأول: توافد رسائل الكوفيين على الإمام× طالبين منه القدوم لمصرهم، وهذا الأمر هو صريح قول الإمام×: «وكانا آخرَ مَن قدم عليّ من رُسُلكم..إلخ».
والمقصود من هذين الشخصين هما: هانئ بن هانئ السُّبيعي[178] وسعيد ابن عبد الله الحنفي، وهو ذلك البطل المقدام الّذي استقدمه الإمام الحسين× يوم عاشوراء فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يميناً وشمالاً، وهو قائم بين يدي الإمام الحسين× يقيه السّهام طوراً بوجهه، وطوراً بصدره، وطوراً بيديه، حتّى سقط الحنفي إلى الأرض[179].
الأمر الثاني: الإشادة بشخصيّة مسلم، حيث أعطاه الإمام× صكّ السّفارة وأيّده بهذه الكلمات؛ لتكون له وثيقة بين أهل الكوفة، وقد وصفه الإمام بأوصاف فريدة، فقد وصفه بالأُخوّة الإيمانيّة، والقرابة الرّحميّة، حيث قال: «أخي وابن عمّي»، والوثاقة حيث قال: «وثقتي من أهل بيتي».
وهذه الكلمة الوجيزة لم تصدر من أيِّ أحدٍ، وإنّما صدرت من المعصوم الواقف على نفسيّات البشر.
والأوصاف المذكورة هي من أهمّ الصّفات الّتي ينبغي أن يتّصِف بها السّفير، ولا أقلّ من وصف الوثاقة.
والأمر الثالث: تحديد صلاحيّة مسلم، وهو اكتشاف الوضع السّياسي في الكوفة، ومدى صدق القوم فيما كتبوه، ومن المؤكّد أنّه لا تُناط هذه الصّلاحيات إلّا بمَن كانت له معرفة بشؤون المجتمع وأحوال الناس[180].
سفر مسلم إلى العراق:
خرج مسلم بن عقيل ومعه الصكّ الحسينيّ في منتصف شهر رمضان من سنة ستين للهجرة، خرج من مكّة المكرّمة يريد العراق على طريق المدينة، ولمّا وصلها صلّى في مسجد الرّسول وزار بُقعتَه المقدّسة وودّعه الوداع الأخير، وجدّد هنالك المواثيق المؤكّدة. وقد ضلّ الدليلان اللذان استأجرهما مسلم بن عقيل وماتا، وكان مع مسلم قيس بن مسهر الصّيداوي وعمارة بن عبد الله السلولي، وعبد الرحمن بن عبد الله الأزدي.
وقد كتب ابن عقيل× كتاباً يخبر الحسينَ× بموت الدليلين، وقد تلاعبت الأقلام المأجورة لتضيف إلى ذلك الكتاب (التَّطيّر)[181]، وهو الّذي لا يصدر عن مثل مسلم بن عقيل من أبناء هذا البيت الطّاهر جزماً.
ومضت الأيام والليالي ومسلم يجدّ السير، وقد كان يحمل بين ثنايا صدره الشّوق للوصول إلى بلدة الكوفة؛ ليحقّق أمر سيده ومولاه الحسين× والّذي هو متفرّع عن أمر الله تبارك وتعالى.
وهناك نزل في بيت الموالي العظيم المختار بن أبي عبيدة الثّقفي والّذي كان من وجهاء الكوفيين، ومن خاصّة البيت العلوي وممَّن أخلص للعلويين.
وهنا انثال الكوفيون على بيت المختار بعد ما سمعوا بقدوم مسلم بن عقيل إليه، وأحاطوا به يبايعونه، وهنا تعرف وتقف على نفسيّة مجموعة ممَّن بايعوا مسلم، وذلك عن طريق كلمات بعض الأجلّة، أمثال عابس بن شبيب الشّاكري وصحبه المخلصين، وحبيب بن مظاهر الأسدي وسعيد الحنفي، والّتي يُبيّنونَ فيها أنّهم وطّنوا أنفُسَهم على ما عليه الإمام الحسين× وسفيره مسلم بن عقيل، وبالفعل فقد ثبت هؤلاء الأطهار في الدّفاع عن آل نبيِّهم فيما بعد؛ حفظاً للعهد، وأداءاً لأجر الرسالة.. وهكذا فقد بلغ عدد مَن بايع مسلماً× ثمانية عشر ألفاً، أو خمسة وعشرين ألفاً، وقيل: أربعون ألفاً. ولمّا أحصى ديوان مسلم ذلك العدد الكثير من المبايعين كتب إلى الإمام الحُسين× مع عابس الشّاكري، وقيس بن مسهر الصّيداوي يخبره باجتماعهم على رأيه وطاعته، وانتظارهم لقدومه، وفيه يقول: «الرائد لا يكذبُ أهلَه»[182].
ومن جانبٍ آخر لمّا بلغ والي الكوفة النُعمانَ بن بشير الأنصاري اجتماع الكوفيين على مسلم بن عقيل×، وبيعتهم له، رقى المنبرَ وأخذ يتحدّث باللين والشدّة. ممّا أثار ضغينة مَن وُجد من بنيّ أُميّة، واعتبروا أنَّ حديث والي الكوفة مثارٌ للضّحك والاستياء، وطافح بالضّعف والمسكنة. ممّا جعل البعض منهم يكتب كتاباً ليزيد يُخبرهُ بحال والي الكوفة وبيعة أهلها لمُسلم بن عقيل، فاستشار يزيدُ سرجونَ فيمَن يولّيه، فأشار إليه بعبيد الله بن زياد، فكتب إليه يزيد يخبره بالتحرُّك من البصرة إلى الكوفة، ودخل الكوفة متنكّراً بزيّ ريحانة المصطفى| الحسين× وقد هتف الحرس بصوت عالٍ: مرحباً يا بن رسول الله، وهو لا يكلّمهم إلى أن وافى القصر، وقد أغلقه النعمان بن بشير، فأشرف من أعلى القصر يقول: ما أنا بمؤدّ إليك أمانتي يا بن رسول الله، وما لي في قتالك من إرب، فغضب ابن زياد منه وقال له: افتح لا فتحت فقد طال ليلك، وسمعَه مَن كان خلفه فرجع إلى الناس يقول: إنّه ابن مرجانة وربِّ الكعبة، فتقهقر النّاس إلى منازلهم فُرقاً من سطوة ابن زياد، وأخذ الرَّجُل يُحدّث جليسَه بالشرِّ المقبل من جراء هذا الطّاغي، وفي الصّباح ألقى اللعين خُطبتَه في جمعٍ من النّاس، وهددّهم وتوعدّ مَن خالفه الشرَّ ومَن أطاعه الخيرَ[183].
فحصل الخذلان في المجتمع الكوفي بعد أن سجن ابنُ زياد منهم الأشراف، وخوّف منهم البقيّة، وطمّع الآخرين، وهكذا بقى ابن عقيل سفير ريحانة المصطفى’ وحيداً فريداً. بعد ما سمع الناس مقالة ابن زياد، وكانت المرأة تأتي ابنها أو أخاها فتقول: انصرف، الناسُ يكفونك، ويجيء الرَّجُل إلى ابنه وأخيه فيقول: غداً يأتيك أهلُ الشام[184]، فخرج ابن عقيل يمشي وحيداً إلى أن وقف على باب امرأة يقال لها طوعة[185]، فرأها فسلّم عليها وردّت عليه السّلام، فقال: «اسقيني» فسقته ودخلت إلى بيتها، وخرجت فرأت مُسلماً جالساً على باب دارها، قالت: يا عبد الله، ألم تشرب الماء؟ قال: «بلى»، فقالت له: فاذهب إلى أهلك فسكت، ثمّ أعادت القول ثانية فسكت مُسلم، فقالت له: أصلحك الله، لا يصلح لك الجلوس على باب داري ولا أحلّه، قال: «يا أمةَ الله، ما لي في هذا المصر أهلٌ ولا عشيرةٌ، فهل لك أجرٌ ومعروف أن تُضيّفيني سوادَ هذه الليلة، ولعلّي مكافئك بعد هذا اليوم؟» قالت: ومَن أنت حتّى تكافيني عليه؟[186]، فكأنّي بها تسأله : هل أنت رسول الله’ الّذي يجازي المُحسنين، أو ابن عمّه أمير المؤمنين، أو أخوه عقيل أو حتّى ابنه مسلم الّذي أرسله قُرّةُ عيني الحسين والّذي يقال أنّه دخل الكوفة.. كأني به دمعت عيناه، وقال: «أنا مسلم بن عقيل!» فقالت: معذرةً يا ابن أخ الكرّار لم أعرفك[187]. عندها أدخلته إلى دارها.
(نصاري)
|
خانت واغدرت مسلم الكُفّار نادت يبعد عيوني الاثنين |
وعندها بقي يعبد الله تبارك وتعالى إلى طلوع الفجر، جاءت إليه بماء ليتوضّأ به، وقالت: يا مولاي، ما رأيتُك رقدت البارحة؟! فقال لها: «اعلمي أنّي رقدتُ رقدةً فرأيتُ في منامي عمّي أمير المؤمنين× وهو يقول: الوحى الوحى، العجلَ العجلَ، وما أظنُّ إلّا أنّه آخر أيّامي من الدُّنيا».
فتوضأ وصلّى صلاة الفجر، وكان مشغولاً بدعائه إذ سمع وقع حوافر الخيول وأصوات الرّجال، فعرف أنّه قد أُتي إليه، فعجّل في دُعائه، ثمّ لبس لامة حربه، وقال: «يا نفس، اخرجي إلى الموت الّذي ليس له محيص»، فقالت المرأة: سيدي أراك تتأهب للموت؟ قال: «نعم، لا بدّ لي من الموت. وأنتِ قد أدّيتِ ما عليك من البرّ والإحسان، وأخذتِ نصيبَك من شفاعة رسول الله’». فاقتحموا عليه الدّار وهم ثلاثمائة، وقيل سبعون فارساً وراجلاً، فخاف أن يحرقوا عليه الدار، فخرج وشدّ عليهم حتّى أخرجهم من الدار، ثمّ عادوا عليه، فحمل عليهم وهو يقاتلهم، حتّى قتل منهم واحداً وأربعين رجلاً، فأخذوا يصعدون فوق السّطوح ويرمونه بالنار والحجارة والسّيوف والرّماح، إلى أن أُثخن بالجراح، وعجز عن القتال فأسند ظهره إلى جنب جدار، فضربوه بالسّهام والأحجار، فخرّ إلى الأرض، فتكاثروا عليه وأوثقوه أسيراً وأخذوا يسحبونه، وطوعة تنظر إلى هذا المنظر المروّع وكأنّي بها:
(قطيفي)
ظلّت تنخيهم يهل كوفان ارحموه
هذا ابن أخو الكرّار حيدر لا تسحبوه
خلوه يمشـي ابراحته گلبه شعبتوه
خافوا من الله ما لكم مذهب ولا دين
صاحت يمسلم يا عظمها خجلتي بيك
اشبيدي وأنا حُرمة وضعيفة اومگدر أحميك
لو يتركونك چان أفت گلبي وداويك
انچان اسلمت من كيدهم سلّم على حسين
گلها يطوعه اليوم ما تحصل سلامة
اوصيچ چان ابهل البلد نزلوا يتامه
گولي ترى مسلم يبلّغكم سلامه
واجرچ على الله والنبيّ سيّد الكونين
ثمَّ أركبوه على بغلةٍ واجتمعوا حوله، ونزعوا سيفه، عند ذلك يئس من نفسه، فدمعت عيناه، ثُمَّ قال: «هذا أوّل الغدر».
|
خذوا مسلم لعد گصـر الإمارة |
ثمّ استسقى الماء فلم يُسقَ، وأدخلوه على اللعين ابن زياد وهو بحالةٍ يُرثى لها، فلم يُسلِّم على اللعين، فأخذ ابن زياد يشتمُ الحُسينَ وأميرَ المؤمنين÷ ويتوعّده.
آه:
|
على ابن زياد طب راعي الشّهامة اوگام الطّاغي يشتمه ابكلامه اويشتْم احسين سبط النبي الأكرم |
وعندما أمرَ اللعين بقتله×، صعدوا به على سطح قصر الإمارة، وهو يُسبِّح الله ويستغفره، ثُمَّ توجه إلى جهة الحُسين× وقال: «يا أبا عبد الله، هذا سلام وداعٍ وإلى يوم اللقاء يتجمّع الأحبّة والرُّفقاء».
(بحراني)
من صعد فوگ الگصـر حلو الجهامة
اتوجّه لبو اليمة گبل چتله بسلامه
سلّم عليه او مدمعه على الوجن هامي
سلّم وجسمه من الطعن والضـرب دامي
اوناده يبو السجّاد هذا آخر سلامي
اولا تگرب الكوفة يبن سيّد تُهامة
ثمّ رفع اللعين سيفه فضرب مسلماً بالسّيف على عُنقه حتّى قطعها، ثُمَّ ألقى بجثتِه من أعلى القصر بلا رأسٍ، ثُمَّ أتبعها الرأس الشَّريف، وا مسلماه، وا مظلوماه، وا سيداه[188]:
انچتل مُسلم وأبو اليمّة ابدربه
اجاه الخبر عنه اوذاب گلبه
اعله زينب صاح والمدمع ايصبه
على اثيابه اوعليه امخيّم الهم
يزينب جيبي بت مسلم حميدة
جابتها اومسح على الراس بيده
انشدته من اعرفت مسلم فجيده
امسحت راسي تگله ليش يا عمّ
يگللها أبوچ أنا وبناتي
اخواتچ والمگدر كون ياتي
متشوفين كل ذلّة بحياتي
لمن بالطف علي يجري المحتم
آجركم الله يا مؤمنين، ثمَّ أُخذت جثّتُه وجثةُ هانيء بن عروة وربطوهما بالحبال وأخذوا يجرونهما بالأسواق:
المگدر جره وشاعت أخباره
رموه الگوم من گصـر الإمارة
وهاني انچتل بعده اوبگت داره
مظلمة ولا بعد واحد يصلها
أويلي:
|
مصيبتهم مصيبة تصدع الأجبال |
||
|
|
(أبو ذية) |
|
|
عادة اليستجير يكون ينجار |
||
|
فإن كُنتِ لا تدرين ما الموتُ فاُنظري |
المحاضرة الحادية عشرة: معطيات آية المودّة
|
عينُ جُودي لمُسلمِ بنِ عقيلِ |
****
|
أويلي والرجس آمر بچتله |
***
(أبوذية)
|
الكِدر كل عام عام الفرح ياعم على المخلوگ
كلّه إيكون ياعم |
***
قال الله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾[191].
تشتمل هذه الآية على أبحاث أتعرّض لبعضها:
البحث الأول: ما هو سبب نزول هذه الآية المُباركة؟ لأنّ بعض أسباب النزول لها دخلٌ في الوصول إلى معنى الآية المطلوب؟
رُوي عن ابن عباس أنّه قال: إنَّ رسولَ الله’ قدم المدينة، فكانت تنوبه فيها نوائب وحقوق، وليس في يديه سِعة لذلك، فقالت الأنصار: إنّ هذا الرجُل قد هدانا الله على يديه، هو ابنُ أُختكم ينوبه نوائب وحقوق، وليس في يديه سِعَة، فاجمعوا له من أموالِكم ما لا يضُركم فتأتونه فيستعين به على ما ينوبه. ففعلوا، ثُمَّ أتوه فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّك ابنُ أُختنا، وقد هدانا الله على يديك، وينوبُك نوائب وحقوق، وليس عِندك لها سعة، فرأينا أن نجمع من أموالنا فنأتيك به، تستعين به على مَن ينوبَك وهو ذا، فأنزل الله هذه الآية: ﴿ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾[192].
البحث الثاني: معنى هذه الآية على لسان أهل البيت^، فقد ذكر أصحابُ التفسير ما زاد على العشرين رواية[193] في أنَّ المودّة في القُربى بمعنى المودّة في أهل بيت النبيِّ|.
فعن أبي جعفر× أنّه سُئل عن قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال: «هُم الأئمّة الذّين لا يأكلون الصّدقة ولا تحلّ لَهُم»[194].
وأمّا عن طريق المخالفين فقد ذكر صاحبُ الكشّاف في تفسير هذه الآية المباركة الحديث الطّويل: «ألا ومَن مات على حُبِّ آلِ مُحَّمدٍ مات مغفوراً له»[195]، وكذا ذكره الرّازي في تفسيره، وأضاف وأنا أقول: «آلُ مُحّمدٍ’ هم الّذين يَؤول أمرهُم إليه، فكلّ مَن كان أمرهُم إليه أشدّ وأكمل كانوا هُم الآل، ولا شكَّ أنَّ فاطمة وعلّياً والحسَن والحُسينَ كان التعلّق بينهم وبين رسول الله’ أشدَّ التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هُم الآل»[196].
وفي صحيح البُخاري في تفسير هذه الآية قال: «عن سعيد بن جُبير إنَّ القربى قُربى آل مُحمّدٍ (صلى الله عليه وسلم)»[197].
البحث الثالث: في أنَّ (إلّا) في الآية هل تُفيد الاستثناء المتّصل أم الاستثناء المنفصل؟
فعلى القوّل الأول، وأنَّ الاستثناء مُتّصل، يعني: أنّ الله تباركَ وتعالى أَمرَ النبيَّ الأكرمَ| أن لا يسألهم أَجراً إلّا أجراً واحداً، وهو أن يودّوا أهلَ بيتهِ.
وأنّ جوب مودّتهم وجعلها أجراً للرّسالة إمّا كان ذريعةً إلى إرجاع الناس إليهم فيما كان لهم من المرجعيّة العلميّة، فالمودّة المفروضة على كونها أجراً للرّسالة لم تكن أَمراً وراءَ الدّعوة الدينيّة من حيث بقائها، فالآية في مؤدّاها هذا لا تُغاير مؤدّى سائر الآيات النافية لسؤال الأجر، مثل قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾[198] المحكيّة عن لسان النبيِّ الأكرم’، ومؤدّى هذه الآية الشّريفة: إنّي لا أسألكم عليه أجرا،ً إلّا أنّ الله لمّا أوجبَ عليكم مودّةَ المؤمنين، ومن جُملتهم قرابتي، فإنّي أحتسب مودّتكم لقرابتي وأعدّها أجراً لرسالتي[199].
أمّا على الثاني، ومِن كونِ الاستثناء مُنفصل، يعني: أنَّ الكلام تمَّ في قوله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًٍ﴾، فيكون حال الرّسول الأكرم’ حال الأنبياء الآخرين في أنّه لم يسألهم أجراً أبداً، ثُمَّ إلّا المودّة في القُربى جُملةٌ أُخرى ليست هي الأجر؛ وهذا خلاف ظاهرِ الآية كما صرّح به السّيد العلّامة&[200] بأنّ الاستثناء مُتّصل ولا قرينة على أنّه منفصل.
البحث الرابع: الاستدلال بهذهِ الآية على عصمة أهل البيت^، فإنّ الله تبارك وتعالى أمرَ النبيَّ الأكرم| أن يطلب الأجر، وهو المودّة في القُربى، ومن المُستحيل أنّ الله يطلُبُ المودّة لشخصٍ ـ مهما كان ـ إذا لم يكن هذا الشخص محفوظاً من كُلِّ نقصٍ دائماً وأبداً، وإلّا لما أمر بطلب المودّة، فكيفَ يَوُدّ الله تبارك وتعالى أشخاصاً يخطئون ويعصون؟! فما دام أنّ الله تبارك وتعالى أمر بمودّتِهم إذاً هم معصومون من كلّ نقصٍ دائماً وأبداً.
ولكنّ هؤلاء القرابة لرسول الله| ما أُعطوا المودّة، فخالفَ جمعٌ من المسلمين أوامر الله تبارك تعالى فيهم.
روى الشيخ الصدوق& في الأمالي: أَنّه لمّا قُتل الحُسين× وهجم القوم على رحله، فرّت العيالات والأطفال ـ كالطّيور الهاربة ـ من النار، فمن جُملة مَن هرب من الأطفال طفلَي مُسلم بن عقيل، ولمّا أُلقي القبضُ عليهما جيء بهما إلى الكوفة، وأُدخلا على ابن زيادٍ، فأمر بهما أن يُزجّا في السّجن، حتّى إذا مرَّت عليهما سنة كاملة وهُما في السّجن، وقد ضاقت صُدورهُما، فقال الصغيرُ ذات يومٍ لأخيه الكبير: أخي، يُوشكُ أن تُفنى أعمارُنا في هذا السّجن، فلِمَ لا نُخبرُ السجّان بخبرنا ونُعرّفه أنفُسنا لقُربِنا من رسولِ الله|؟! ولمّا أن جاء إليهما السجّان بقوتهما قام إليه الصّغيرُ وقال له: يا هذا أتعرف مُحمّداً المُصطفى نبيّ هذهِ الأُمّة؟ قال: وكيف لا أعرفُ النبيَّ!! فقال له: أوَ تعرف ابنَ عمّهِ عليّ بن أبي طالبٍ×؟ قال: وكيف لا أعرفه وهو إمامي!! فقال له: يا شيخ، أوَ تعرف مُسلمَ بنَ عقيلٍ؟ قال: نعم، فقال له: يا هذا نحنُ أولادُه، فما لك وما لنا لا ترحمنا لصغر سنّنا؟!
فلمّا سَمِعَ السجّان بكى وانكبَّ عليهما يُقبّلهما وهو يقول: نفسي لكما الفِداء، والله، ما كان لي علم بأنَّكما ابني مُسلمِ وأنّ أميرَ المؤمنين عمّكُما، سيّديَّ هذا بابُ السّجن مفتوح، فخُذا أيَّ طريقٍ شئتُما وسيرا في الليل، واكمُنا في النهار.
قال الراوي: فأطلقهما مِن السّجن وخرجا وهُما لا يدريان إلى أينَ يتوجّهان، فجعلا يسيران في شوارع الكوفة، حتّى إذا كان وقتُ طلوع الفجر، ودخلا في بستانٍ هناك فكمُنا، فمرّت عليهما جارية فسألتهما عن حالِهما، فأقسما عليها أن لا تُخبر أحداً بخبرهما، وعَلِما منها أنّها موالية لعمّهما، فقصّا لها خبرهما، فقالت لهما: سيّدي امضيا معي فإنّ مولاتي موالية لعمّكما ومحبّة لكما، فجاءا معها حتّى إذا وصلا سبقتهما الجارية على مولاتها وأخبرتها، فلمّا سَمعت قامت لاستقبالهما وقالت لهما: ادخلا البيت على الرّحب والسّعة، ورفّهت عليهما.
هذا وقد استُخبر ابنُ زياد بخروجهما من السّجن فأمر مُناديه أن يُنادي: مَن جاءني بولدَيّ مُسلم له عند الأمير الجائزة العظمى، فصار أجلاف أهلِ الكُوفة يُفتّشونَ عليهما ويطلبونهما، ومن جملتهم زوج تلك المرأة الّتي أجارتهما.
قال: فلمّا جَنَّ اللّيلُ أقبل زوجُها وقد أتعب نفسه في طلبهما رجاء الجائزة، فقالت له زوجتُه: أين كُنتَ اليوم وأرى عليك آثارَ التَعب؟! فحكى لها بما نادى مُنادي ابنِ زيادٍ، وقد أتعب نفسه في طلب الطّفلين، فلمّا سَمِعت الحُرّة قالت له: ما لك وذريّة عبد المطّلب، أما تخشى أن يكون مُحمّدٌ غداً خصمُك؟ فقال لها: دعيني من هذا. فبينما هِي تكلّمُه ويُكلّمها إذ سَمِعَ هَمهَمةً في داخل الحجرة فقال لها: أيّ شيءٍ أسمعه، هل عِندنا أحد؟! فأعرضت وتلجلجت. فقام اللعين وأخذ الضياء ودخل الحجرة وإذا بالطفلين قائمينِ يُصلّيانِ، حتّى إذا فرغا قال لهُما:مَن أنتُما؟ فقالا: أولادُ مُسلم بن عقيل، أجارتنا هذه الحُرّةُ، فقال اللعينُ: أتعبتُ نفسي وفرسي في طلبكما وأنتما في داري!!
ثمّ رفع يده ولطم الكبير على وجهه، وجاء لهما بالحبال فأوثقهما كِتافاً.
فقالا له: ما لكَ تفعلُ بِنا هذا الفعل وامرأتُك أضافتنا؟ أما تخاف الله فينا؟ أما تُراعي يُتمنا وقربنا من رسول الله؟ فلم يعبأ اللعينُ بكلامهما، ولا رقَّ لهما فتركهما في الحجرة يبكيان حتّى الصّباح، ثمّ أخرجهما من داره وتبعتُه امرأتُه وولَدُه وعبدُه. هذا وامرأتُه تتوسَّل به وتحالفَه وتُذكّرَه الله، حتّى جاء بِهما إلى جانب الفُراتِ ليقتلهما، فالتفتَ إلى عَبده وقال له: خذ السيف واضرب عنقيهما وأتني برأسيهما، فأخذهما العبد وأراد قتلهما، فقالا له: يا هذا، ما أشبه سوادك بسوادِ بِلال مؤذّن رسولِ الله... يا هذا، لا تقتلنا فإنَّك إن قتلتنا يُخاصمُك رسولُ الله يوم القِيامة، فقال لهما، مَن أنتُما؟! فقالا: نحنُ أولاد مُسلم بن عقيل.
قال: فانكبَّ العبدُ عليهما يُقبّلهما، ورمى السيفَ من يده وألقى بنفسه في الفُرات، وعبر إلى الجانب الآخر، فصاح به مولاه عصيتني؟ فقال له: عصيتك لمّا عصيتَ الله، فقال اللعينُ: والله، لا يتولّى قتلَهما أحدٌ غيري. فأخذ السّيف وأتى إليهما فلمّا همَّ بقتلهما جاء إليه ابنُه وقال له: أبه، ارحمهما لقُربهما مِن رسول الله ولصغرِ سِنّهما، فلم يعبأ بِه، فلمّا رأيا صُنعه تباكيا، ووقع كُلٌّ منهما على الآخر يُودّعه ويعتنقه، والتفتا إليه وقالا له: يا هذا، لا تدعنا نُطالبُك بِدمنا أمام رسولِ الله يَومَ القيامة، خذنا حيّين إلى ابنِ زيادٍ يصنعُ بنا ما يشاء. فقال: ليس إلى ذلك من سبيل، فقالا: يا هذا بِعنا في السّوق وانتفع بأثماننا ولا تقتلنا، فقال: لا بُدَّ من قتلكما، فقالا له: ارحم يُتمنا وصِغر سنّنا، وإن كنت عَزِمت على قتلنا فدعنا نصلّي لربّنا ركعتين.
قال: صلّيا ماشئتما إن نفعتكما الصّلاة. فلمّا فرغا من الصَّلاة شهر سيفه وقدّمَ الكبير ليضرَب عُنقَه، فقال له الصغير: اقتُلني قبل أخي. فقال الكبيرُ: إنّي لا أُحبُّ أن أرى أخي قتيلاً. فشهر سيفه وضرب الكبير فقتله، فوقع عليه الصغير يتمرّغُ بِدمِ أخيه وهو يُنادي: وا أخاه، ثُمَّ اجتذب وضربَ الصَّغير فقتله، وقطع رأسيهما وحملهما في مُخلاة[201] له ورمى بأبدانهما في الفُرات، وسار برأسيهما إلى ابن زيادٍ، فلمّا مَثُل بين يديه ووضع المُخلاة، فقال له ابنُ زياد: ما معك؟ فأخرج إليه الرأسين فكشف عن وجهيهما وإذا هما كالقمرين.
فقال له: قتلتهما؟ قال: طمعاً بالجائزة، قال: واين ظفرتَ بِهما؟
قال في داري، وإنَ زوجتي أجارتهما، فقال له ابنُ زياد: ما عرفتَ لهما حقَّ الضيافةِ وقتلتهما! ولو جئتني بِهما أحياءً لضاعفتُ لك الجائزة، ثُمّ قال: ويلك، ما قالا لك حين أردت قتلهما؟ قال: قالا لي: إرحمْ يُتمنا ولا تقتلنا فيكون خصمُك مُحّمدٌ يومَ القِيامة، وامضِ بنا إلى ابن زياد حيّين، وإن شئتَ بعنا في السوق وانتفع بثمننا. فقلتُ لهما: لا بُدَّ من قتلكما، فنظر ابنُ زيادٍ إلى جُلسائه وقال: ما أفضّه وأجفاه.
قال الراوي: فأمر ابنُ زيادٍ بقتله فقُتل (عليه لعائنُ الله)، وأمرَ بالرأسين أن يُدفنا في المكان الّذي قُتلا به[202].
أقول: ليت اللعين فعل مثل هذا الفعل برأسِ وجسدِ أبيهما مُسلمِ بنِ عقيلِ.
يقول الراوي: لمّا صعدوا بمُسلم إلى السّطح قال: يا بكر، دعني أُصلّي لربيِّ ركعتين، فقال: صلِّ. فصلّى مُسلمُ حتى إذا فرغ من الصّلاة وجّه وجهه نحو مكّة، وقال: «السلام عليك يا أبا عبد الله، السلامُ عليك يا بن رسول الله»، فصيح به: يا بكر، عجّل عليه، فشهر بكر سيفَه وضرب عُنق مُسلم، ورمى برأسه من أعلى القصر إلى الأرض وأتبع جسده، وأراد أهلُ الكوفة في ذلك اليوم إرضاء ابن مرجانة بفعلهم، فجاؤوا لِمسلم ولهاني ووضعوا الحبال برجليهما، وجعلوا يسحبونهما بالأسواق[203]. ورحِم الله الشاعر حيث يصف حال الشيعة وبُكائِهم على مُسلم:
|
بكتك دماً يا ابنَ عمّ الحُسين |
وذلك لمّا وصل خبر استشهاد مُسلم× للحسين× وكان في زرود، كأني بِه استرجع قائلاً: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، ثُمَّ إنّه× عمد إلى خيمة النساء ونادى الحوراء زينب‘ قائلاً لها: «أئتيني بحميدة»، ولمّا أقبلت إليه وضعها في حِجره، وأخذ يمسحُ على رأسها.
(نصّاري)
|
أخذ بت مُسلم من الخِيَم بيده يمسح راسها ابحسـرة شديدة |
***
(عاشوري)
|
غده يمسح دمعها ومحني ظلعه أبوچ
آنه يگلها ويهل دمعه |
المحاضرة الثانية عشرة: كيفيّة اختيار الصديق
|
كيف يَصحُوا بما تَقولُ اللّواحي مَن سَقتْه الهُمومُ أنكَد راحِ |
***
|
گال احسين يرجال
الحميّة |
(أبوذية)
|
اچفوف الكدر يصحابي
لونكم أحشّمكماورُوحي
تون لونكم |
***
من حِكَم أبي مُحمَّد الحسن الزّكيّ×: «وإن نازعتك إلى صُحبةِ الرّجالِ حاجة، فاصحبْ مَن إذا صحبتَه زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا أردتَ معونةً أعانك، وإن بدت منك ثلمة سدّها، وإن رأى منك حسنةً عدّها»[206].
من موعظة لإمامِنا المجتبى×، ألقاها على أحد أصحابه، وهو يرزح تحت أعباء الآلام الشّديدة من أثر السُّم الّذي أوهى قوته، وذلك الصاحب هو جُنادة بن أبي أميد (أُمية)، دخل عليه فقال: سيّدي لِمَ لا تُعالج نفسَك؟
قال×: «بأيِّ شيءٍ أعالجُ الموتَ؟! وهل يُفيدني العِلاج، وقد ألقيتُ الطائفة الكُبرى مِن كبدي؟!»، فطلب مِنه الموعظة، فوعظه وهو على فِراشه بِكلمةٍ بليغةٍ موجزةٍ مشتملةٍ على عِدّة وصايا وهذه واحدةٌ مِنها، علّمه فيها بصّفات الصّاحب الّذي إن احتاج أن يُصاحبَ أحدٌ أحداً فليصحب هكذا إنسان، ونحنُ عندما نقول: صاحب ورفيق وزميل وقرين وخليل وحبيب، هذه كُلُّها تُعطي معنى: أخ «ورُبَّ أخٍ لك لم تلده أُمُّك»[207]، والمرء يُعرف بصاحبه ورفيقه، إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ.
قال الشاعر:
|
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فَكُلُّ قرينٍ بالمُقارن يقتدي[208] |
ولعلَّ الشاعر القائل:
|
صاحبْ أخاً ثقةً تُحضـى بصُحبتهِ فالطبعُ مُكتسبٌ من كُلِّ مصحُوبِ |
كان يقصد هذا المعنى نفسَه، يُمثّل أحد الحكماء صُحبة السّفيه وذِي الأعمال السّيئة بالدُخان يقول: «إذا لم تكتسب نفس تِلك الحالة الذميمة الّتي هي فيمَن صحبته من الأشرار، تكون صُحبة هكذا إنسان مثل الدُخان، فالدخان إنْ لم يقتُلك، فإنّه يدخل في عينك فيُهمل دمُوعَها». ولأهمّية الأُخوّةِ في الدّين الإسلامي أولى هذا الجانب العناية التامّة دستور الإسلام ونبيُّ الإسلام وأئمّةُ الإسلام، فالقُرآن تارةً يقول: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾[210]، وأُخرى يأمر بتقوية الروابط الأخويّة والعِلاقات الإسلاميّة بقولِه: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾[211]، أمّا النبيّ الأكرم’ فيكفي فعلُه عن قوله عندما آخا بين المهاجرين والأنصار، وأمرهم بالتآزر والتعاون.
وللإمام أمير المؤمنين× كلمةٌ من كلماته الرائعة ـ وكلّ كلامه رائع ـ: «إنّما أنتم إخوانٌ على دينِ الله، ما فرّقَ بينَكُم إلّا خُبثُ السّرائر وسُوءُ الضَمائِر، فلا توازرون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا توادون، ما بالكم تفرحون بالقليلِ من الدُنيا تدركونه، ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه»[212] ومضافاً إلى ذلك، وضع× ميزاناً ليفرّق به المُسلمُ المؤمنُ صديقَه من عدّوِه؛ ليعرف مَن عليه أن يُصاحبه ويُصادقه، ومَن الّذي عليه أن يبتعد عنه ويتجنّبه.
بهذا الميزان أو هذه النصيحة والبيان أرشد الإنسان الواعي المتديِّن، فالإنسان إنْ اتّبعَ ما وُضع له من خُطوطٍ وعلاماتٍ على الطّريق أدّى به سيرُه إلى (محطة الكرامة ومرسا السّلامة)، وإلّا فنصيبُه الخُسران والضّلال والندامة، ماذا قال× «أصدقاؤك ثلاث وأعداؤك ثلاث: فأصدقاؤك: صديقُك، وصديقُ صديقِك، وعدّو عدوِّك. وأعداؤكَ: فعدوّكَ وعدوُّ صديقِك وصديقُ عدوِّك»[213]. ومِن هذه الحكمة الّتي يعسر أن يأتي بِها أحدٌ غير بابِ مدينةِ العلم، بهذهِ الوجازة مع الإحاطة الكاملة بالأمرين المُهمّين، وهُما تعيينّ الصّديق والعدوّ، ويكشف الصّديقَ المُتلوّنَ الّذي لا يُعرف له وجه، ورَحِم الله الشاعر:
|
فأمّا أن تكونَ أخي بصدقٍ فأعرفَ مِنك غثّي من سميني |
وكلّ ما ذكرناه مِن الشعر والنثر لم تخرج عنه كلمة الإمام الحسن×، بل جمعت كلَّ ما فيه وزيادة، اُنظر إلى موعظته ووصفه الناجع والنافع: «إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك، وإذا طلبت منه معونةً أعانك»، وفي الحقيقة هذه هي الأخلاق الحميدة والصّفات الرفيعة والمجيدة، فصُحبة الرّجال الأخيار والشرفاء والعظماء في سيرتِهم وعلمهم هي التي تكسب المرء جمالاً وكمالاً، ثمَّ أعطى الصّاحب الصّالح والكريم وصفاً آخر، فقال: (وإذا خدمته صانك)، بخلاف اللئيم الذي يقول في صانع المعروف له ما يقوله في غيره على حدّ سواء.
|
إذا أنتَ أكرمتَ الكريمَ ملكتَه وإنْ أنتَ أَكرمتَ اللئيمَ تمرّدا[215] |
ثمّّ قال×: «وإذا طلبت مِنه معونةً أعانك» أيّ: لا يسلّمك عندَ النّكبات، ولا يتخلّى عَنك في الأزَمات، والصاحب رصيدٌ غالٍ وطاقةٌ تردّ بِها الصّعاب من الأُمور، وقد قيل فيه: الصاحبُ نِعم العون على النوائب، نوائب الدهر وصروفه.
اُنظر إلى أصحاب الإمام الحسين× النخبة الصالحة، والصّفوة الّتي كتب الله لها الفوز والسّعادة في نصرة أ بي عبد الله الحُسين×، وأخذ عددهم يتكامل شيئاً فشيئاً بين مُفارقٍ يُلقي الله النّورَ في قلبه فينصرف عن طريقه الأوّل إلى ما عليه الحُسين× فيُصبح من أنصاره، وبين مسيحيٍّ يُحصي الله له السّبب بعد السّبب لوضوح سبيل الحقّ، وإذا به بعد نصرانيتهِ مُسلمٌ مؤمنٌ، يقارعُ الظّالمين، وينصر الدّين. وبين مَن كان في الانتظارِ، منهم (حبيب بن مظاهر الأسدي) الذي كان للحُسين× حبيباً مُنذ عهد الرسول|، كتب إليه الحُسين×: «بسم الله الرحمن الرحيم: من الحُسين بن عليِّ إلى الرّجُل الفقيهِ حبيبِ بن مظاهر، أمّا بعد فقد نزلنا كربلا والسّلام». يعني مجرّد إشارة، وإلّا فهو على موعدٍ ثابتٍ من أمير المؤمنين× بأنّه سَيُوفّق إلى شهادةٍ عظيمة بعد مرور زمانٍ، وبعد قتل مُسلمِ× وتَوجّه الحُسين إلى العراق، كان ينتظر؛ لأنّه من أهل علوم المنايا والبلايا، بالإضافة إلى ما سبقه من الوعد، بينما هو جالس وإذا بالباب تُطرق، وكانت زوجتُه قد تفاءلت بورودِ كتابٍ كريمٍ من رَجُلٍ كريمٍ، وذلك عِندما غصّت بلُقمتها، طُرقت الباب، أقبل حبيب، فتح الباب وإذا برجُلٍ يحمل الرّسالة، استلم منه الرّسالة، ثُمَّ قال: ادخُل على الرّحب والسّعة، فشكره الرّسول وقال: الأمرُ أسرع من ذلك.
دخل حبيب فتح الرسالة قرأها تهاملت دمُوعه، تحنّت ظلُوعه، أمّا زوجتُه ـ جزاها الله خيراً ـ أخذت تبكي كَبُكاء الثَّكلى، ثمَّ أخذت تحثُّه على الإسراع بالذهاب إلى الحُسين×، ضامِنةً له مُباراة أطفالِه ومُداراتهم، وهو يمتحنُ صبرَها وولائَها، فأخذ يُظهر التباطُأ والتكاسُل، فالتفتت إليه بآهات وحسراتٍ وأنين وحنين.
ذكر أصحابُ السّير: أنّ الحُسين× عِندما قسّم الرايات على أصحابه، وكانت اثنتي عشرةَ راية، أبقى راية، فقال له بعضُ أصحابه: مُنَّ عليَّ بحملها، فقال له: يأتي إليها صاحبُها، بينما الحُسين× وأصحابه في الكلام وإذا بغبرةٍ ثائرةٍ، فالتفتَ الإمام× وقال: إنَّ صاحب هذه الراية قد أقبل، فلمّا صار حبيبُ قريباً مِنَ الإمام المظلُومِ تَرجَّل عن جواده، وجعلَ يُقبّلُ الأرضَ بين يديه، وهو يبكي، فسلَّم على الإمام وأصحابه، فردّوا عليه السلام[216]، فسمعت زينب بنتُ الإمام أمير المؤمنين×، فقالت: مَن هذا الّذي أقبل؟ فقيل لها: حبيبُ بن مظاهر، فقالت: اقرؤوه عنّي السّلام. فلمّا بلّغوه سلامها، لطم حبيبُ على وجهه، وحثا التُرابَ على رأسه، فقال: ومَن أكون حتّى تُسلّم عليَّ بنتُ أميرِ المؤمنينَ[217]؟!
(نصّاري)
|
أنه منين وتسلّم عليه بنت المرتضـى حامي الحمية |
(أبوذية)
|
للخالك أنصار احسين وحدوا |
المحاضرة الثالثة عشرة: حدود الصداقة
|
لله آلُ الله تُـسرِعُ بالسـُّرى |
(مجاريد)
|
وينَ الصُميده يحضـر الحين |
|
|
|
|
لحّگ يحيدر يبو الحسنين |
|
***
رُويَ عن إمامِنا الصّادق× أنَّه قال: «لا تكون الصّداقةُ إلّا بحُدودِها، فَمَن كانت فيهِ هذه الحُدود أو شيءٌ منها فانسبه إلى الصّداقة، ومَن لم يكن فيه شيءٌ منها فلا تنسبه إلى شيء من الصّداقة: فأوّلها: أن تكونَ سريرتُه وعلانيتُه لك واحدة. والثّاني: أن يَرى زَينَك زَينَه وشَينَك شَينَه. والثّالثة: أن لا تُغيّره عليك ولايةٌ ولا مال. والرّابعة: أن لا يمنعك شَيئاً تناله مقدرتُه. والخامسة ـ وهي تجمُع هذهِ الخصال ـ: أن لا يُسلّمكَ عِندَ النكباتِ»[219].
إنّ عالمنا اليوم يتعطّش إلى إقامة علاقات وطيدة تُبنى على أُسس المودّة والتآلف والوئام والانسجام، ففي الوقت الّذي يسوده التشاؤم والحقد والعنف والإرهاب، تراه يتشوّق بلهفةٍ إلى كيمياء المحبّة، إذ إنَّه العلاج الناجح لداء التوتّر... وأفضل معلّم يعلّمنا ذلك هو الباري} في كتابه الكريم الّذي جعل (الرحمن والرحيم) من مفتتحات سوَره وآياته المباركة في الإشارة إلى أنّ رحمته لا تقتصر على المؤمنين والصّالحين وحسب، بل إنّ رحمته العامّة تشمل الصّالحين والطّالحين وتستوعب كلّ شيء في الوجود؛ إذ قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾[220].
ومن هذا المنطلق يقول الإمام أمير المؤمنين×: «أبلغ ما تُستدرُّ به الرَّحمة أن تُضمر لجميعِ النَّاس الرَّحمة»[221].
وما الحديث الّذي افتتحنا به كلامنا إلّا واحد من مئات الأحاديث الّتي حثّت على المحبّة والأُخوّة والصّداقة.
وهذا الحديث المرويّ عن إمامِنا الصّادق× في مصادرَ عديدة ما هو إلّا ثمرة من ثمرات الحُبّ والمودّة الّتي كان يحملها إمامُنا الصّادق× تبعاً لآبائه وجدّه رسولِ الله’، وما أخذه من الباري إلّا أنَّ الإمامَ الصّادق× ذكر حُدوداً خمسة في حقيقة الصّداقة، إذا حصل الإنسان عليها أو على بعضها فهو الصّديق، وإذا لم يحصل ولا على واحدة منها ـ على أقل تقدير ـ فهو ليس من أهل الصّداقة.
لكن هذا لا ينفي أن يكون نضيراً في الخلق وما شابه ذلك، إلّا أنّه ليس بالصديق الّذي يكون من الخواصّ.
الأوّل: «أن تكونَ سريرتُه وعلانيتُه لك واحدة»
وهذا هو الشرط الأول من هذه الشروط الخمسة، فمتى ما كان الّذي تريد أن تُصادقَه يحمل هذا الشّعور وهذا المبدأ فهو أهلٌ للصّداقة.
قال بعض الأكابر: «لعلّ المراد أن يكون كلّ قوله موافقاً لضميره، وإلّا لكان نفاقاً منافياً للصداقة، لا أن لا يكتم سرّاً من أسراره؛ إذ كتمان بعض السرّ من باب الحزم قد يكون مطلوباً، كما دلَّ عليه بعض الروايات»[222]، ومثل هذه الشّروط الخمسة لا يتحقق العلم بوجوده إلّا بالمجالسة المتعدّدة، والمخالطة المتكرّرة، والمعاشرة الظّاهرية، أو بشهادة حاله وغيرها.
الثاني: «أن يرى زينك زينه وشينك شينه»: بحيث يريد ويكره لك ما يريد ويكره لنفسه، بحيث لا يورّطك في فعلٍ هو لا يرتضيه لنفسه أبداً، ويعتبر ذلك عاراً عليه؛ لأنّك مرآة له في أصل الإيمان، فضلاً عن الصّداقة الّتي هي أخصُّ من مطلق الإيمان، وينهاك سرّاً عن بعض ما لا يرتضيه هو لنفسه؛ لأنَّ هذا الشرط يريد أن يجعلك مع صديقك شخصين في صورة واحدة؛ إذ ورد في بعض حقوق المسلم على المسلم: «أن يُديمَ نصيحَته... ويحبّ له من الخير ما يحبّ لنفسه، ويكره له من الشّر ما يكره لنفسه»[223].
والثالث: «أن لا تُغيّرَه عليك ولاية ولا مال»: بأن تكون صداقته بعد وجدان الحكومة والمال كما يكون قبله بلا تفاوتٍ، وهي نادرة[224].
وهذا الشّرط هو محكّ الأصدقاء، فكم من صديقٍ أخلصَ صداقتَه لصديقه، وكانت سريرته وعلانيته واحدة، ويرى زين صديقه زينه، وشينه شينه؟ لكن ما أن وصل إلى الولاية، أو حصل على بعض المال الّذي ليس لصديقه منه نصيب، حتّى تراه قد انقلب ورجع القهقرى. وهناك أمثلة عديدة في التاريخ، أذكر نموذجاً واحداً على نحو التذكير يشابه ما تريد ببعض الاعتبارات.
روى مُحمّد بن عليّ الصّوفي قال: استأذن إبراهيم الجمّال& على أبي الحسن عليّ بن يقطين الوزير، فحجبه، فحجَّ عليُّ بن يقطين في تلك السّنة، فاستأذن بالمدينة على مولانا موسى بن جعفر فحجبه، فرآه ثاني يومه، فقال عليّ بن يقطين: يا سيّدي ما ذنبي؟ فقال: «حجبتُك لأنّك حجبتَ أخاك إبراهيم الجمّال، وقد أبى الله أن يَشكُرَ سعيَك أو يغفر لك إبراهيم الجمّال، فقلت: سيّدي ومولاي، مَن لي بإبراهيم الجمّال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟
فقال: إذا كان الليل فامض إلى البقيع وحدك من غير أن يعلم بك أحدٌ من أصحابك وغلمانك واركب نجيباً[225] هناك مُسرَّجاً. قال: فوافى البقيع وركب النجيب، ولم يلبث أن أناخه على باب إبراهيم الجمّال بالكوفة، فقرع الباب، وقال: أنا عليّ بن يقطين. فقال إبراهيم الجمّال مِن داخل الدار: وما يعملُ عليّ بن يقطين الوزير ببابي؟! فقال عليُّ بن يقطين: يا هذا، إنَّ أمري عظيم، وآلى عليه أن يأذن له، فلمّا دخل قال: يا إبراهيم، إنَّ المولى× أبى أن يَقبلني أو تغفرَ لي، فقال: يغفر الله لك. فآلى عليّ بن يقطين على إبراهيم الجمّال أن يطأ خدّه، فامتنع إبراهيم من ذلك، فآلى عليه ثانياً ففعل، فلم يزل إبراهيم يطأ خدّه وعليُّ بن يقطين يقول: اللهمَّ اشهد. ثمّ انصرف وركب النجيبَ وأناخه من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر× بالمدينة، فأذن له ودخل عليه فقبله»[226].
فلاحِظ كيف أنَّ الإمام× لم يقبل عليَّ بنَ يقطين لعمله هذا، وكيف كان تصرّف عليِّ بن يقطين تجاه صديقه إبراهيم الجمّال؟!
الرابع: «أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته» والرابع من هذه الحدود الخمسة أن لا يمنع الصّديق صديقَه شيئاً هو قادر على تقديمه له، سواء كان هذا الشيء مالاً أو جاهاً أو مواساةً أو ما شابه ذلك؛ لأنَّ كلمة (الشَّيء) تشمل الجميع، وإلّا يكون قد قصّر في حدٍّ من حدودِ الصّداقة.
والخامس: «أن لا يُسلّمك عند النكبات» وقد عبّر الإمام× عن هذه الخصلة بأنّها تجمع الخصال كُلَّها؛ لأنَّ الصّديق إذا لم يُسلّم صديقَه عند النكبات فقد حقّق: بأنّه ما منع صديقه شيئاً تناله مقدرته، ولا تغيّر بالولاية ولا المال، وهكذا، فكلّما احتاجه صديقه كان عنده في الشدائد والمحن، في الرّخاء والشّدّة.
والنَكبة ـ بالفتح ـ هي ما يُصيب الإنسان من الحوادث. ومعنى الإسلام هنا الخذلان والإلقاء إلى الهلكة. يقال: أسلم فلان فلاناً إذا خذله ولم ينصره، أو إذا ألقاه إلى الهلكة ولم يحمِهِ من عدوّه[227].
وقد روي عن الإمام أمير المؤمنين× أنّه قال: «النّفسُ الكريمة لا تؤثّر فيها النَكَبات»[228].
وهذه الكلمة أشبه ما تكون حلّاً لمَن سلّمه صديقه للنكبات، وخذله في المُهمّات، والحلّ هو أن لا يتأثّر بذلك، بل يصبرُ ويتوكّل على الله تبارك وتعالى.
وأروعُ مثالٍ سطّره التاريخُ في حدود الصّداقة ما ذُكر عن أصحاب الإمام الحُسين×، فلقد بالغوا في غاية المجهود، وزادوا في تحقيق الحدود، فشملهم الله تبارك وتعالى بواسع رحمته، ورفيع درجته، وإنّ العاقل يقف لهم بكُلِّ إكبارٍ وإجلالٍ، لعظيم ما قدّموه في عاشوراء، وجليل ما حقّقوه لسّيد الشهداء أرواحنا له الفداء فترى الكبير يحثُّ الصّغير، والحرّ يُقويّ عزيمةَ المولى، والزّوجة تُشجّعُ زوجَها، والولد يتقدّم والدَه وهكذا. فلم يسلّموه عند النكبات.
فناصروا الرّسول وبضعته البتول، وناصروا أمير المؤمنين، وبهجة المختار فصاروا بذلك نِعمَ الأنصار، وقد أعمى الله لهم ولأجلهم مَن كثّر السواد.
فقد سُئل عبدُ الله الرّياح القاضي الأعمى عن عمائه، فقال: كنتُ حضرتُ كربلاء، وما قاتلتُ فنمت فرأيتُ شخصاً هائلاً قال: أجب رسول الله، فقلت: لا أطيق، فجرّني إلى رسول الله فوجدتُه حزيناً وفي يده حربة، وبسط قُدّامه نطعٌ وَمَلَكٌ قَبلَه قائم، في يده سيف من النار، يضرب أعناق القوم وتقع النار فيهم فتحرقهم، ثُمَّ يُحيون ويقتلهم أيضاً هكذا، فقلت: السّلام عليك يا رسولَ الله، والله ما ضربتُ بسيفٍ ولا طعنتُ برُمحٍ ولا رميتُ سهماً، فقال النبيُّ’: ألستَ كثّرتَ السّواد فسلَّمني وأخذ من طستٍ فيه دم فكحّلني من ذلك الدّم فاحترقتْ عيناي فلمّا انتبهت كُنتُ أعمى[229].
نعم والله، لقد ضرب أصحاب الإمام الحسين× أروع الأمثلة، ويكفيك ما قاله الإمام الحسين× في حقّهم كما روى ذلك زينُ العابدينَ وسيّدُ السّاجدين×، ونصَّ عليه العالمُ الكبير الشّيخ المُفيد& حيثُ قال: «فجمع الإمام الحُسين× أصحابَه عند قرب المساء، قال عليُّ بن الحُسين زينُ العابدين× فدنوت منه لأسمع ما يقول لهم، وأنا إذ ذاك مريضٌ، فسمعت أبي يقول لأصحابه: «اُثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السّراء والضراء، اللهمَّ إنّي أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوّة، وعلّمتنا القرآن، وفقّهتنا في الدّين، وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدةَ فاجعلنا من الشّاكرين.
أمّا بعد: فإنّي لا أعلم أصحاباً أوفى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهلَ بيتٍ أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي خيراً، ألا وإنّي لأظنُّ أنّه آخر يوم لنا من هؤلاء، ألا وإنّي قد أذنت لكم فانطلقوا جميعاً في حلّ ليس عليكم منّي ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً». فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا[230] عبد الله بن جعفر: لِمَ نفعل ذلك، لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبداً. بدأهم بهذا القول العبّاس بن علي× واتبعته الجماعة عليه فتكلّموا بمثله ونحوه»[231].
فنصروا إمامهم بكلّ ما أُوتوا من قوّةٍ ومن هنا ترى أنَّ المؤرّخينَ عندما يمرّون بسيرة حبيب يقفون له ولأمثاله إجلالاً لمواقفه النبيلة مع أهل بيت العصمة والطهارة.
فقد ذكر بعض أهل المقاتل أنَّ حبيبَ بنَ مُظاهر كان ذات يوم بالكوفة واقفاً عند عطّارٍ يشتري صبغاً لكريمته، فمرّ عليه مسلم بن عوسجة فالتفت إليه حبيب وقال له: يا مُسلم، إنّي أرى أهل الكوفة يجمعون الخيل والرجال والأسلحة! فبكى مسلم، وقال: صمّموا على قتال ابن بنت رسول الله|. فبكى حبيب ورمى الصبغ من يده، وقال: لا والله، لا تصبغ هذه إلّا من هذهِ. وأشار إلى نحره، ثمّ سار حتّى وافى كربلاء..[232]، وأنّه لمّا رأى كثرة العساكر وتصميمهم على حرب الحسين أقبل إلى الحسين، وقال له: سيّدي، إنَّ ها هنا حيّ من بني أسد أفتأذن لي أن أمضي إليهم وأدعوهم إلى نُصرتك؟ فقال له الحسين×: «بلى امضِ» فانسلّ حبيب في جوف الليل حتّى إذا جاء إلى ذلك الحيّ اجتمعوا عليه ورحّبوا به، ثُمَّ قالوا له: ما حاجتُك؟ فقال إنّي أتيتُكم خيرَ ما أتى به وافد على قومه، جئتكم أدعوكم إلى نصرة ابن بنت رسول الله|، وهذا ابن سعد أحاط به، وأنتم عشيرتي أطيعوني تنالوا شرف الدّنيا والآخرةِ، والله، لا يُقتل أحد منكم إلّا وكان لمحمّد| رفيقاً يوم القيامة. فقام إليه رجل يُسمّى عبد الله بن بشير فقال: يا حبيب! أمّا أنا فأوّل مَن يجيبك إلى هذه الدّعوة، وها أنا ماضٍ معك. قال: فتبادروا حتّى اجتمعوا تسعون رجلاً وأقبلوا معه يريدون الإمام الحسين×[233].
وذكر بعض أرباب العزاء: أنّه لمّا كان اليوم العاشر من المحرّم جلس حبيب بإزاء خيمة النساء واضعاً رأسه في حجره يبكي، ثمّ رفع رأسه فقال: آهٍ آهٍ لوجدِكِ يا زينب يوم تُحملين على بعير ضالع يُطافُ بك البلدان، ورأس أخيك الحسين أمامك. وكأنّي برأسي هذا مُعلّق بلبان الفرس، تضربه برُكبتيها. فضربت زينب رأسها بعمود الخيمة وقالت: «بهذا أخبرني البارحة، لوددت أن أكون عمياء». ثمَّ جاء حبيب واستأذن الحسين× للبراز، فأذن له، فحمل على القوم وهو يقول:
|
أنا حبيب وأبي مُظهر |
ولم يزل يقاتل حتّى قتلَ من القوم مقتلةً عظيمةً، فحمل عليه بديل بن صريم العقفاني فضربه بسيفه، وحمل عليه آخر من تميم فطعنه برُمحِه فوقع إلى الأرض، فذهب ليقوم فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسّيف فسقط إلى الأرض، فنزل إليه الحُصين فاحتزَّ رأسه.
وروي عن أبي مخنف قال: لمّا قُتل حبيب هدّ قتلُه الحُسينَ× فجاء إلى مصرعه، وقال: «عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي»[234]. إنّا لله وإنّا إليه راجعون، قُتل والله أسدٌ من آساد الله، يذبَّ عن حرمِ الله، رَحِمكَ الله يا حبيب، لقد كُنت شُجاعاً فاضلاً، تختم القرآن في ليلةٍ واحدة.[235]
وفي ذلك يقول الشيخ محمد السماوي&:
|
إن يهدّ الحسين قتلُ حبيبٍ |
فأخذ الحسين× ينظر يميناً وشمالاً، فلم يرَ أحداً من أنصاره إلّا مَن صافح التُرابُ جبينَه، ومَن قطع الحمامُ أنينَه، فنادى يا حبيب بن مظاهر، ويا زُهير بن القين، ويا مسلم بن عوسجة، ويا فلان ويا فلان. وكأنّي به بلسان الحال:
|
ليش أنادي اوما تجيبون النده |
وذُكر أنَّ الحُسين× عندما وصل لحبيب استعبر باكياً وقد بان الانكسار في وجه الحسين×، وقال: «عند الله أحتسب نفسي وحُماة أصحابي».
|
اجاه احسين شافه ودمّه مسفوح وعاين بيرغه اعلى الأرض مطروح جذب ونّه اومنه غابت الروح |
وكأنّي بالحُسين× ينصَرفُ عنه وعن بقيّة أصحابه رضوان الله عليهم، وبلسان الحال:
|
تعنّه احسين واوچب بالمعارة |
(أبو ذية)
|
اچفوف الگدر يصحابي لونكم احشّمكم اوروحي تُوِّن لونكم |
(تخميس)
|
لمّا رأى السّبطُ أصحابَ الوفا قُتلوا |
|
|
|
وخلّفوا في سويدَ القلب نيرانا |
المحاضرة الرابعة عشرة: الصديقون والشهداء
|
ما السّيفُ ما الرمحُ لولا خفقةُ العلمِ |
***
(فائزي)
ظهري انكسـر خويه وانته اللي كـسرته
ماني أخوك اشلون أخوك اليوم عفته
انته التجيب الماي وانته الكافل انته
اتخلّي العقيلة ابلا ولي بين آل أُميّة
اشلون اردّن للخيم والخيم ظلمة
عبّاس خويه نومتك علگاع هضمه
ما بين طفل اليرتجيك وبين حُرمة
كلساع تگول اهسا يجيب الماي ليّه
ولكن انقطعت آمالهم بعد ما علم الجميع ـ كباراً وصغاراً ـ أنَّه على المشرعةِ، دامي الودجين، وكأنّي بأبي عبد الله الحُسين× يخبر بذلك.
(نصّاري)
يخويه أيّست سكنه امن الماي
تجي يمّي يخويه او توگف احذاي
يخويه امن العطش رادت تجي اوياي
او تگلك وين وعدك يا مشكّر
يخويه ما درت لنك رميّة
وهي برجواك تسجيها أُميّة
يخويه امنين اجت ليك المنيّة
او تگظي بالعطش والشّمس والحرّ
يخويه ليش هلساعة عفتني
غبت عنّي يخويه اوضيّعتني
مهو افراگك شعب گلبي اوفتّني
اونارك بالگلب يا خوي تسعر
(أبو ذية)
|
فضل عبّاس ما ينعد وجوده |
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾[238].
الآية المباركة جاءت ضمن آيات أُخر من سورة الحديد تتحدَّث عن مجموعة مُهمّةٍ من المسائل الأخلاقية والتربوية، كان آخرها الّذين يتصدّقون بأموالهم، حيث قال تعالى فيها: ﴿إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾[239] ثم جاء دور الآية الّتي نحن بصددها.
ويمكن أن نركّز حديثنا في ضوء الآية المباركة على بعض المقاطع التّالية:
الإيمان بالله ورسلِه:
لقد بنى القرآن الكريم الصّفات والجزاء على الإيمان بالله ورُسُله، ومن هنا كان من المهم جدّاً أن نُركّزَ البحث عليه.
فالإيمان بالله ورُسلِه هو الاعتقاد الرّاسخ بأنَّ الله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ بصفاته الذاتية والجلالية والجمالية حيّ قيّوم، إلى آخر ما وصف به الباري نفسه تبارك وتعالى، وأنّه بعث الأنبياء والرّسل لا نفرّق بين أحدٍ من رُسله.
فمَن انطوى قلبه وانعقدت جوانحه ورسخت عقيدته على هذه المعاني فهو مؤمن بالله ورسله مع كامل الإقرار والاعتقاد.
وأنّ يأتي بأعماله على ضوء ما اعتقد به، ولذا عطف الباري} العمل الصّالح على الإيمان،كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾[240]، فالإيمان بالله وحده أشبه ما يكون بالنظرية الّتي تحتاج إلى تطبيق على الواقع الخارجي؛ ولذا ورد النهي المؤكّد عن ادّعاء مثل هذا الإيمان المفرّغ من محتواه العملي الّذي يكون مناسباً لما يعتقده ويؤمن به، كما روي ذلك في روايات عديدة عن النبي وأهل بيته الأطهار^.
منها: ما رواه الشّيخ الكليني& في الكافي عن سُماعة قال: قلت لأبي عبد الله×: أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال: «إنّ الإيمان يشارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان»، قلت: فصفهما لي، فقال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله، والتّصديق برسول الله|، به حُقنت الدّماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل به، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة؛ إنَّ الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن، وإن اجتمعا في القول والصفة»[241].
ومحل الشّاهد في هذا الخبر هو قوله×: «والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به»، فلا بدَّ من العمل بالإضافة للإيمان القلبي.
وقريب منه ما عن حمران بن أعين عن أبي جعفر× قال: سمعتُه يقول: «الإيمان ما استقرَّ في القلب وأفضى به إلى الله، وصدّقه العمل بالطّاعة لله والتسليم لأمره...»[242].
فالمقصود من الإيمان ما انعقد عليه القلب، وصدّقته الجوارح بالعمل الصّالح المرضي عند الله ورسوله وأوليائه.
صفات المؤمنين بالله ورسله:
بعد أن بيّنا أنَّ حقيقة الإيمان بالله ورسله لا يُقتصر فيها على المقام النظري، بل لا بدَّ من التعدِّي إلى مقام العمل، جاء الآن الدور لبيان ما هي الصّفات المترتبة على الإيمان بالله والرُسُل؟
وفي الجواب نقول: إنَّ الآية المباركة ذكرت أنَّ هؤلاء لهم مقام عظيم ليس عند الناس فحسب، بل لهم مقام رفيع وشأن عظيم عند الله}، وهذا المقام والصّفة هي ما ذكره الباري} بقوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾.
وقبل الخوض في معنى الصّدِّيق والشّهيد في الآية المباركة، أودُّ أن اتعرّضَ لبعضِِ الآيات الّتي تناولت موضوعَ الإيمان بالله ورُسله. فهناك آيات عديدة ذكرت مقامات ومنازل للذين آمنوا بالله ورسله غير ما ذكرته الآية الشريفة.
مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾[243]، ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾[244]، وغيرها من الآيات. ففي الآية الأُولى جعل الباري منزلة الّذين آمنوا وعملوا الصالحات الجنّة. وفي الآية الثانية جعلهم الباري المصداق الوحيد للمؤمن. وهكذا هو الأمر في عديدٍ من الآيات، فقد تجاوزت الآيات الّتي تعرّضت لمادّة الإيمان المائة، بل أكثر.
ثمَّ نعود إلى الصّفة الّتي وصف الباري} بها الّذين آمنوا به تعالى وبرسله هي: (الصدِّيق والشّهيد) حيث قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ْ ﴾
فما المراد بالصدّيق والشّهيد؟ لقد تكرّرت هاتان اللفظتان في القرآن الكريم كثيراً، وقد وصّف الباري بعض الأنبياء بالصّدّيق في بعض الآيات.
منها: قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾[245].
وقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴾[246].
وقوله تعالى: ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ ﴾[247] إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. وكذلك الأمر بالنسبة للفظة (الشّهيد) فقد تكررَّ ذكرها في القرآن الكريم كثيراً، مثل قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴾[248].
والمقصود بالصدِّيقين في الآية المباركة «هم الّذين سرى الصّدق في قولهم وفعلهم، فيفعلون ما يقولون ويقولون ما يفعلون»[249].
يعني أصبح الصدق ملازماً لهم ولا ينفكّ عنهم، لكون الصّيغة من صيغ المبالغة، وهي دالّة على الكثرة، وهي النموذج التّام للصّدق[250].
وقد روي عن أهل البيت^ أنَّ فاطمة‘ «كانت صدِّيقة»، فعن أبي عبد الله الصّادق× أنَّه قال: «لفاطمة‘ تسعة أسماء عند الله} فاطمة، والصدّيقة، والمباركة...» إلى آخر الحديث[251]. وسيأتي أنَّ بعض الرّوايات وسّعت من مصاديق الصدّيقين والشّهداء.
وأمّا الشُّهداء فهو جمع شهيد من مادّة (شُهود) بمعنى الحضور مع المشاهدة، سواء كانت بالعين المجرّدة أو البصيرة، وإذا أُطلقت على (الشاهد) كلمة شاهد وشهيد فالسّبب هو حضوره ومشاهدته في المكان، كما يُطلق هذا المصطلح على (الشُهداء في سبيل الله) بسبب حضورهم في ميدان الجهاد.
إلّا أنَّ المراد من (الشُّهداء) في الآية ـ مورد البحث ـ قد يكون الشّهادة على الأعمال، كما يُستفاد من الآيات القرآنية الأُخرى، فالأنبياء شهداء على أعمال أنفسهم، ورسول الإسلام شاهد عليهم وعلى الأُمّة الإسلامية والمسلمون الحقيقيون أيضاً شهداء على أعمال الناس، كما في قوله تعالى: ﴿وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾[252] وغيرها من الآيات. وبناءاً على هذا فإنّ الشّهادة على الأعمال مقام عالٍ، والّذي يكون من نصيب المؤمنين.
واحتمل البعض أنَّ لفظ(شُهداء) هنا يراد به الشّهداء في سبيل الله، أي الأشخاص المؤمنون الّذين لهم أجر وثواب الشهادة يُحسَبون بمنزلة الشهداء.
ومن الطّبيعي أنّه يمكن الجمع بين المعنيين، خصوصاً أنَّ القرآن الكريم أطلق مصطلح (شهيد وشهداء) ـ في الغالب ـ على الأعمال وما إلى ذلك[253].
وأما الصدّيق والشّهيد في أحاديث أهل البيت^ فهُما أوسع من ذلك، ففي (حديث الأربعمائة) من الخصال عن أمير المؤمنين× قال: «والميّتُ من شيعتنا صدِّيقٌ شهيدٌ، صدَّق بأمرِنا، وأحبّ فينا وأبغض فينا، يريد بذلك الله مؤمن بالله وبرسوله، قال الله ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ »[254].
ووصفت بعض الرّوايات المرويّة عن النبيّ الأكرم| أشخاصاً مُعيّنين بكونهم صدّيقين، حيث قال|: «الصّدّيقون ثلاثة: عليُّ بن أبي طالب، وحبيب النجّار، ومؤمن آل فرعون»[255]، وقال|: «لكلّ أُمّة صدّيق وفاروق، وصدّيق هذه الأُمّة وفاروقها عليُّ بن أبي طالب×»[256]، هذا هو صدّيق الأُمّة الأوّل.
وأمّا صدّيقُها الثّاني فهو أبو الفضل العبّاس ابنه×، حيث شهد له الإمام الصّادق× بذلك، وأعطاه هذا الوسام في زيارته له×، حيث قال إمامُنا أبو عبد الله الصّادق×: «أشهدُ لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة..»[257].
فأبو الفضل العباس× هو الصّديق من حيث اللُغة، لأنّه×كان دائم التصديق لله ولرسوله ولإمامه ـ الإمام الحسين× ـ وهو الّذي كان عمله يصدّق قوله، وهو أيضاً كان المبالغ في الصّدق، وأنّه كان الّذي لم يختلج في قلبه شكٌّ في كُلِّ ما أمر الله به، وهو الصّديق من حيث الاصطلاح أيضاً؛ لأنّه× كان النموذج الأفضل، والمصداق الأمثل ـ بعد الأئمّة الأطهار^ ـ لمَن آمن بالله ورسوله وأطاع الله ورسوله كما كان هو× في مُقدّمة الشّيعة وطليعتهم والسّبّاق في متابعة أئمّة أهل البيت^ ومشايعتهم؛ لأنَّ الشّيعي هو مَن شايع عليّاً× والأئمّة من بنيه الّذين سمّاهم القرآن بأهل البيت^، والتزم متابعتهم، والسير على هُداهم، وكيف لا يكون أبو الفضل العباس× كذلك وهو ابن الإمام أمير المؤمنين×، وأخو الإمامين الهُمامين الحسن والحسين÷، وقد تلقّى تربيته الأخلاقية والعلمية الرّاقية في أحضانهم ومدرستهم[258].
هذا هو المقام الأوّل لأبي الفضل العبّاس× وهو مقام التّصديق.
المقام الثّاني: وهو مقام الشّهادة، ومن المعلوم أنّ أبا الفضل× ممَّن آمن بالله ورسوله وأوصياء الله ورسُلِهِ، فهو ممَّن نال مقامَ الشّهادة بكلا معنييها المتقدِّمين، بمعنى مَن شاهد وحضر، أو بمعنى مَن قُتل في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان كذلك أبو الفضل العبّاس×، فإنَّ مواقفه المشرّفة في كربلاء وفي يوم عاشوراء وغيرها، لهي خير دليلٍ على ما قاله الإمام زينُ العابدين× في حقّ عمّه أبي الفضل العبّاس×، وأجلى بُرهانٍ على جدارةِ أبي الفضل العبّاس× لنيل هذا الوسام المنيف، وسام (الشهيد المحتسب) كما وسّمه الإمام الصّادق× بهذا الوسام العظيم، وذلك حيث خاطبه في زيارته المعروفة بقوله: «أشهدُ أنّك قُتلتَ مظلوماً» فلم يكن شهيداً فحسب، بل شهيد مظلوم؛ لأنَّ الأعداء من دناءتهم وخسّتهم لم يبارزوه وجهاً لوجه، وإنّما اغتالوه في كمين لهم، فقتلوه غيلةً وغدراً، ومن قساوتهم وغلظتهم لم يكتفوا بقتله بضربة وضربتين، وإنّما قطّعوه بسيوفهم إرباً إرباً، بعد أن بتروا يدَيه وأبانوا رجليه، وأصابوا عينه، وخسفوا رأسَه وقتلوه مظلوماً فصدق عليه أنّه الشّهيد المظلوم كما شهد له الإمام الصادق× بذلك[259].
الأجر والنور:
بعد أن بيّنت الآية المباركة أنَّ للّذين آمنوا بالله ورُسلِه مقاماً عظيماً عند الله تبارك وتعالى، وهو مقام الصّدِّيقين والشّهداء، ذكرت أيضاً أنَّ لهم أجراً ونوراً، حيثُ قالت: ﴿ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ﴾ والّتي فسّرها بعض العُلماء بأنَّ لهؤلاء أجراً من نوع أجر الصدِّيقين والشُهداء، ونوراً من نوعِ نورهم[260].
وهكذا هو الحال في قمر العشيرة ونورها أبي الفضل العبّاس×، فإنَّ له مقاماً عند الله تبارك وتعالى زائداً على مقام الصدِّيقين والشهداء إذ لا يبقى صدِّيق ولا شهيد إلّا وغبط أبا الفضل العباس×.
ومن هنا روي عن إمامنا زين العابدين× أنّه قال: «رحم الله عمّي العبّاس بن عليّ، فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه، حتّى قُطعت يداه فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنَّة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب، وإنّ للعبّاس عند الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميعُ الشُّهداء يوم القيامة»[261].
ولعلّ مرجع هذه المنزلة إلى مرتبة المواساة وقوّتها لسيّدهِ أبي عبد الله المظلوم×، والنفس الأبيّة الّتي كانت لا تتحمل سماع صوت الأطفال يتصارخون وينادون: العَطشَ، العَطشَ.
|
أَوَ تشتكي العطشَ الفواطمُ عِنده |
فركب جوادَه ومعه اللواء، وأخذ القربة وقصد الفرات، وأحاط به أربعة آلافٍ ممَّن كانوا موكّلين بالفرات لمنع الحسين وأصحابه منه ورموه بالنبال، فكشفهم وقتل منهم جماعة.
|
وثنى أبو الفضل الفوارسَ نُكَّصاً |
حتى إذا وصل إلى المشرعة رَكَزَ لواءَه ونزل إلى الماء، فلمّا أحسَّ ببُردِ الماء وقد كظّه العطش، اغترفَ غُرفةً ليشربَ، لكنّه تذكّر عطشَ الحسين×، فرمى الماء من يده، وقال: لا والله، لا أشرب الماء وأخي الحسين× عطشان.
|
غرف غرفة ابيمينه اوراد يشـرب اوسكنه والحرم وأطفال رضعان |
ثُمَّ ملأَ القربة وحملها على كتفه، وخرج من المشرعة، فاستقبلته جموع الأعداء، وصاح ابن سعد: اقطعوا عليه طريقَه، ولمّا رأى ذلك منهم حمل عليهم بسيفه:
|
حتّى إذا قطعوا عليه طريقَه |
فرموه بالنبال والسهام من كلّ جانب حتّى صار درعُه كالقُنفذ من كثرة السّهام، فكَمُن له زيد بن ورقاء من وراء نخلةٍ، وعاونه حكيم بن الطفيل على ضربِهِ×، لحظات وجاء إليه أخوه الحسين، فرآه مقطوعَ اليدين، مرضوض الجبين، والسّهم نابت في العين، والعَلَم ممزّق إلى جنبه، والقربة مخرّقة نادى: الآنَ انكَسَر ظهري، الآن قلّت حيلتي، الآن شَمُتَ بي عدوّي، وكأنّي به يُخاطب أبا الفضل بلسان الحال:
|
يبو فاضل يعزّي اوسيف نصـري |
ثمَّ قام أبو عبد الله× وحمل على القوم، فأخذ يضرب فيهم وهو يقول: إلى أين تفرّون وقد قتلتم عَضُدي؟ إلى أينَ تفرّون وقد قتلتم ابنَ والدي؟ ثُمَّ رجع إلى أخيه وانحنى عليه يُقبّله ويبكي، ففاضت روحُهُ الطّاهرة ورأسه في حجر أخيه الحُسين×. رَحِمَ الله مَن نادى: وا عبّاساه، أي وا سيّداه وا عطشاناه.
ثمَّ رجع أبو عبد الله إلى الخيام وكأنّي به:
|
يخويه امودّع الله تظل بالبرّ |
***
|
عبّاس يا حامي الظَّعينةِ والحرمْ |
|
|
|
وتسهّدت أُخرى فعزّ منامُها |
المحاضرة الخامسة عشرة: الشفاعة
|
عَبَسَتْ وُجوهُ القَومِ خَوفَ الموتِ والـ ـعبّاسُ فيهم ضاحكٌ متبسّمُ |
******
|
يعبّاس منته اللي جبتني |
|
|
|
|
وذكـري سهم عـينـي اوريـدي |
|
عن الإمام أمير المؤمنين× قال: قال رسول الله|: «ثلاثة يشفعون إلى الله} فيُشفّعونَ: الأنبياء، ثمَّ العُلماء، ثُمَّ الشّهداء»[265].
للشفاعة أصلٌ واحدٌ يدلُّ على مقارنة الشيئين، من ذلك الشفع خلاف الوتر، تقول: كان فرداً فشفّعته[266].
وأمّا المراد من الشّفاعة في مصطلح المتكلّمين هو أن تصل رحمته سبحانه ومغفرتُه إلى عِباده عن طريق أوليائه وصِفوة عباده، ووزان الشّفاعة في كونِها سبباً لإفاضة رحمته تعالى على العباد وزان الدُعاء في ذلك، يقول سُبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾[267].
وتتّضح هذه الحقيقة إذا وقفنا على أنّ الدُعاء بقولٍ مُطلقٍ، وبخاصّة دعاء الصّالحين من المؤثّرات الواقعة في سلسلة نظام الأسباب والمسبَّبات الكونّية، وعلى هذا ترجع الشّفاعة المُصطلحة إلى الشّفاعة التّكوينية، بمعنى تأثير دُعاء النبيّ| في جلب المغفرة الإلهيّة إلى العباد.
وقد ورد ذكر الشّفاعة في الكتاب والسُّنة.
أمّا في الكتاب الحكيم فقد وردت سُوَر مُختلفة لمناسباتٍ شتّى، كما وقعت مورد اهتمام بليغ في الحديث النبويّ وأحاديث العترة الطّاهرة.
الآيات القُرآنية في هذا المجال على أصناف:
الصّنف الأوّل: ما ينفي الشّفاعة في بادئ الأمر، كقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾[268].
الصنف الثّاني: ما ينفي شُمول الشّفاعة للكفّار، كما يقول سُبحانه وتعالى ـ حاكياً عن الكفّار ـ: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾[269].
الصنف الثّالث: ما ينفي صلاحيّة الأصنام للشّفاعة، يقول سُبحانه وتعالى: ﴿وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ﴾[270].
الصنف الرّابع: ما ينفي الشّفاعة من غيره تعالى، يقول سُبحانه وتعالى: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾[271].
الصنف الخامس: ما يثبت الشّفاعة لغيره تعالى بإذنه سُبحانه، حيث يقول تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴾[272].
الصنف السّادسُ: ما يُبيّن مَن تناله شفاعةَ الشّافعين، يقولُ سُبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾[273].
هذه نظرةٌ إجمالية إلى آيات الشّفاعة.
وأمّا السنّة، فمَن لاحظ الصّحاح والمسانيد والجوامع الحديثيّة يقف على مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشّفاعة توجب الإذعان بأنّها من الأُصُول المسلّمة في الشّريعةِ الإسلاميّة، وإليك نماذج منها:
1ـ قال رسولُ الله|: «لكُلِّ نبيّ دعوة مُستجابةُ، فتعجَّل كُلُّ نبيٍّ دعوتَه، وإنّي اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأُمّتي، وهي نائلة مَن مات مِنهم لا يُشرك بالله شيئاً»[274].
2 ـ وقال|: «إنّما شفاعتي لأهلِ الكبائر من أُمّتي»[275].
3 ـ وقال الإمام زينُ العابدين×: «اللهم صلِّ على مُحمدٍ وآله وشرّف بُنيانَه، وعظّم بُرهانَه، وثقّل ميزانَه، وتقبَّل شفاعَته»[276].
ويمكن أن تُتصور الشّفاعة على وجهين:
الوجه الأوّل: الشّفاعة المُطلقة، بأن يستفيد العاصي مِن الشّفاعة يوم القِيامة وإن فعل ما فعل، وهذا مرفوض في منطق العقل والوحي.
الوجه الثّاني: الشّفاعة المحدودة، وهي الّتي تكون مشروطة بشروط في المشفوع له، ومُجمل تلك الشّروط أن لا يقطع الإنسان جَميع عِلاقاته مع الله تبارك وتعالى ولايقطع وشائجه الرّوحية مع الشّافعين، وهذا هو المقبول عِند العقل والوحي.
وبذلك يتّضح الجواب عمّا يعترض على الشّفاعة من كَونها تُوجب الجرأة وتُحيي روح التمرُّد في العُصاة والمجرمين، فإنّ ذلك من لوازم الشّفاعة المُطلقة المرفوضة لا المحدودة المقبولة.
والغرضُ من تشريع الشّفاعة هو الغرض من تشريع التّوبة الّتي اتّفقت الأُمّةُ على صحّتها، وهو منعُ المذنبين عن القُنوط من رحمة الله وبعثهم نحو الابتهال والتّضرّع إلى الله رجاءَ شُمول رحمته إليهم، فإنَّ المُجرم لو اعتقد بأنَّ عصيانه لا يُغفر قطُّ، فلا شكّ إنّه يتمادى في اقتراف السّيئات، باعتقاد أنَّ تركَ العصيان لا ينفعه في شيءٍ، وهذا بخلاف ما إذا أيقن بأنّ رُجوعَه عن المعصية يغيِّر مصيرَه في الآخرة، فإنّه يبعثه إلى ترك العصيان والرُجوع إلى الطّاعة.
وكذلك الحال في الشّفاعة، فإذا اعتقد العاصي بأنّ أولياءَ الله قد يشفعون في حقّه إذا لم يُهتِك السِّتر، ولم يبلغ إلى الحدّ الّذي يُحرم من الشّفاعة؛ فعند ذلك رُبما يُحاول تطبيق حياته على شرائط الشّفاعة حتّى لا يُحرمها.
شرائط شمول الشفاعة:
1 ـ عدم الإشراك بالله تعالى: وقد تقدَّم في الأحاديث السابقة والآيات.
2 ـ الإخلاص في الشّهادة بالتّوحيد: قال رسولُ الله|: «شفاعتي لِمَن شَهِد أن لا إله إلّا الله مُخلصاً، يُصدِّق قلبُه لسانَه، ولسانُه قلبَه»[277].
3 ـ عدم كونه ناصبيَّاً: فعن الإمامِ الصّادق×: «إنّ المؤمن ليشفع لحميمه إلّا أن يكونَ ناصباً، ولو أنَّ ناصباً شفع له كُلُّ نبىٍّ مرسَل ومَلَك مُقرَّب ما شفعوا»[278].
4 ـ عدم الاستخفاف بالصلاة: فعن الإمام الصّادق×: «لا ينال شفاعتنا مَن استخفَّ بالصّلاة»[279].
5 ـ عدم التكذيب بشفاعة النبيّ|: قال الإمام عليُّ بنُ موسى الرضا×: «مَن كذَّب بشفاعةِ رسولِ الله لم تنله»[280].
هذه هي شرائط شمول الشفاعة.
ثُمَّ إنّ الشّفاعة عِند الأُمم بوجهيها يُرادفها حطُّ الذّنوب ورفع العقاب، ولكن المعتزلة ذهبت إلى أنّ أثرها ينحصر في الرّفع من الدّرجات، وزيادة الثّواب، فهي عِندهم تختصّ بأهل الطّاعة، والسّبب في ذلك؛ لأنّهم حكموا بأنّ مرتكب الكبيرة يُخلّدُ في النار إذا مات بلا توبةٍ، فلمّا رأوا أنّ القول بالشّفاعة الّتي أثرها هو إسقاط العقاب ينافي هذا الحكم، أوّلُوا آياتِ الله، فقالوا: إنّ أثر الشّفاعة إنّما هو زيادةُ الثّواب، وخالفوا في ذلك جميعَ المُسلمين[281].
والأعجب من هذا كلِّه ما ذهب إليه ابنُ تيمية، وتبعه مُحّمد بن عبد الوهّاب ـ مخالفين الأُمّة جمعاء ـ إلى أنّه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة، ولا يجوز للمؤمن أن يقول: (يا رسولَ الله، اشفع لي يوم القِيامة) واستدلّوا عليه بأدلّةٍ مِنها:
1 ـ إنّه مِن أقسام الشّرك، أي: الشّرك بالعبادة والقائل بهذا الكلام يعبدُ الوليّ.
وهذا لاوجه له باعتبار أنّ حقيقة الشّرك هي أن يكون الخضوع والتّذلل لغيره تعالى باعتقاد أنّه إلهٌ أو ربٌّ، لا مطلق الخضوع والتذلل.
2 ـ إنَّ طلبَ الشّفاعة من الغير دُعاء له، ودُعاء غيره سُبحانه وتعالى حرام، يقول سُبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾[282].
ويردُّه أنّ مُطلق دعاء الغير ليس مُحرّماً، وإنَّما الحرام مِنه ما يكون عِبادة له، بأن يعتقد الإلوهية والربوبية في المدعو، والآية ناظرة إلى هذا القِسم بقرينة قوله تعالى: (مع الله).
3 ـ إنَّ طلب الشّفاعة مِن الميّت أمر باطل.
ويرد عليه: إنَّ الإشكال ناجِمٌ من عدم التّعرّف على مَقام الأولياء في كتاب الله الحكيم وسُنّة نبّيه الكريم|، ولو لم يكن للنبيّ| حياة فما معنى التسليم عليه في كُلِّ صباحٍ ومساءٍ في تشهّد كُلِّ صلاةٍ (السّلام عليك أيّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاته)؟! والمؤمنون لا يطلبون الشّفاعة من أجساد الصالحين و أبدانِهم، بل يطلبونها من أرواحهم المُقدَّسة الحّية عند الله سُبحانه، بأبدانٍ برزخية[283].
ثُمَّ إنَّ الحديث جعل الشّفاعة للأنبياء والعُلماء والشّهداء، وأهمّ مصداق، بل المصداق الحقيقي للعلماء والشّهداء هُم أهل البيت^، ومِن هؤلاء أبي الفضل العبّاس×، فقد رُوي عن الإمام الصّادق× أنَّه قال: «كان عمُّنا العبّاس بن علي نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله× وأبلى بلاءً حسناً ومضى شهيداً»[284]، فاجتمعت فيه صفة العلم وصفة الشّهادة، فأيُّ شفاعةٍ تكون له عند الله؟! كيف لا؟! وقد ضحَّى من أجل الدّين ومن أجل الإمامة؛ ولذلك يقول أربابُ المقاتل: لمّا لم يبقَ مع الحُسين إلّا أخوه العبّاس، جاء إلى الحسين× يطلب البراز مِنه قائلاً: هل مِن رُخصة؟ فبكى الحُسين× بُكاءً شديداً، ثُمَّ قال: «يا أخي، أنت صاحِبُ لِوائي، فإذا مضيتَ تفرّقَ عسكري».
فقال العبّاس: «قد ضاق صدري وسئمتُ الحياة». فقال له الحُسين×: «إن عزمت فاستقِ لنا ماءً»، فأخذ قربته وحمل على القوم حتّى ملأ القربة، قالوا: واغترف مِن الماء غُرفة ثمَّ ذكر عطش الحُسين× فرمى بها، وقال:
|
يا نفسُ من بعد الحُسين هوني |
ثمّ عاد فأُخذ عليه الطّريق، فجعل يضربهم بسيفهِ، وهو يقول:
|
لا أرهبُ الموتَ إذ الموتُ زقا |
فضربه حكيم بن طُفيل الطائي السنبسي على يمينه فبرأها، فأخذ اللواء بشماله وهو يقول:
|
والله إن قطعتمُ يميني |
فضربه زيد بن ورقاء الجُهني على شِماله فبرأها، فضَّم اللواء إلى صدره ـ كما فعل عمّه جعفر إذ قطعوا يمينه ويساره في مؤته فضَّم اللواء إلى صدره ـ[285] فحمل عليه رجُل تميمي فضربه بعمودٍ على رأسه فخرَّ صريعاً إلى الأرض، ونادى بأعلى صوته: أدركني يا أخي، فانقضَّ عليه أبو عبد الله كالصقر فرآه مقطوعَ اليمين واليسار، مرضوخ الجبين، مشكوك العين بِسهمٍ، مُرتثّاً بجُراحه فوقفَ عليه يبكي، وضع الحُسين يديه تحت ظهره، وأراد حمله إلى المُخيم.
فقال له العبّاس: بالله عليك، إلّا ما تركتني في مكاني، فقال الحُسين: لماذا يا أخي؟ فقال العبّاس: لحالتين؛ الأُولى: فقد نزل بيَّ الموتُ الّذي لا بُدَّ مِنه، والثانية: إنّي واعدتُ سُكينة بالماء وإنّي مُستحٍ مِنها.
(نصّاري)
|
يخويه احسين خلّيني ابمچاني |
وبينما الحُسين عنده، وإذا بالعبّاس شهق شهقةً وفاضت روحُه الطاهرة[286]، رَحِم الله مَن نادى: وا عبّاساه، وا سيّداه، وا مظلوماه.
(نصّاري)
|
يون ونّه اويونّ حسين ونّات |
قام الحُسين محني الظهر، يكفكفُ دمُوعَه بكُمّه، وهو يُنادي: وا أخاه، وا عبّاساه.
|
يخويه انكسر ظهري اولگدر
أگوم |
(أبوذيّة)
|
انه
صابر لهذا الصار وعداي عزمي
بيك چنت احتزم وعداي |
المحاضرة السادسة عشرة: تأديب الأولاد
|
يا دوحةَ المجدِ مِن فِهرٍ ومن مُضـرِ |
وكأنّي بأُمِّه المفجوعة رملة تُخاطبه:
|
بعدك فلا يسكن ونيني |
(أبو ذية)
|
گلبي من الحزن ورّث ورمله |
***
عن الإمامِ أميرِ المؤمنينَ× عن رسول الله| أنَّه قال: «أدّبوا أولادَكم على ثلاثِ خِصالٍ: حُبّ نبيِّكم، وحُبّ أهلِ بيتِه، وقِراءة القُرآنِ، فإنَّ حملةَ القرآن في ظلِّ الله يومَ لا ظلَّ إلّا ظلُّه مع أنبيائِه وأصفيائِه»[289].
الأخبار في هذه المعاني كثيرة متواترة، وفيها من ضروب التأكيد والترغيب في محبّة أمير المؤمنين عليٍّ والزّهراء والحسنين وأولادهم^ وذمّ بغضهم، ما يُلحق حُبَّهم بأعظمِ الواجبات والفرائض، وبغضهم والانحراف عنهم بأشدّ المحرّمات، بل يجعله من أكبر الكبائر، ونعمَ ما قاله الفرزدق:
|
من معشـرٍ حُبّهم دينٌ وبغضُهُمُ |
ومن هنا صارت محبّتهم حسناتٌ يمدح القرآن الكريم المكتسب لها كما أخرج ذلك مجموعة من عُلماء العامّة، عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ﴾ قال: «المودّة لآل مُحمَّد|»[291].
ومن المعلوم البديهي أنّ الحثَّ على حُبّهم بهذا التأكيد، واهتمام النبيِّ| في بيان فضائلهم ومناقبهم وتنزيلهم منزلةَ نفسِهِ في حبّهم وبغضهم، وسلمهم وحربهم، واختصاصهم بفضائل كثيرة دون غيرهم، أقلّ ما يدلّ عليه هو حجّة الاقتداء بهم في الأحكام الشّرعية، وحجّة أقوالهم وأفعالهم، وحرمة الإعراض عن أحاديثهم وعلومهم[292].
وهذا الحديث يتناول أموراً ثلاثة:
الأمر الأول: حُبُّ النبيّ
محبّة النبيِّ الأكرم| شعارُ المُسلمين، وعلامة الإيمان والمؤمنين، وقد حثَّ هذا الحديث على تأديب الأولاد ـ ذُكوراً وإناثاً ـ على محبّته|؛ لأنَّ محبَّتَه الهُدى إلى تعاليمه، والأخذ بأقواله وأفعاله وسننه|.
فعلى عاتق الأبوين تُلقى هذه المسؤولية لتعليم أولادهم مقامات النبيِّ الأكرم|، ومعاجزه وفضله عند الله تبارك وتعالى، ومكارم أخلاقه وسُننه| حتّى يشتاق الأولاد إلى شخصه الكريم ويُحبّوه، فإذا أحبّوه اقتدوا به، وصار أُسوتهم، وحينئذٍ تكون لهم علامات يُعرفون بها ومن هذه العلامات:
1ـ كثرةُ ذِكره|: لأنَّ مَن أحبَّ شيئاً أكثر من ذكره، وهذه حالة مطّردة تقريباً.
2ـ كثرةُ الشّوق إلى لقائه: فكلُّ حبيبٍ يحبّ لقاءَ حبِيبِه، ولذا كان الأشعريون يُردّدون عند قدومهم المدينة هذه الأرجوزة:
غداً نلقَ الأحبَّة مُحمّداً وصحبَه[293]
3ـ التعظيم له والتوقير، وإظهار الخشوع والانكسار، حتّى عند سماع اسمِه الشّريف|، فعن أبي هارون مولى آل جعدة قال: «كُنتُ جليساً لأبي عبد الله× بالمدينة ففقدني أيّاماً، ثُمَّ إنٍّي جئتُ إليه فقال لي: لم أرك مُنذ أيّامٍ يا أبا هارون؟ فقُلتُ: وُلِدَ لي غُلام، فقال: بارك الله لك فيه، فما سمَّيته؟ قلتُ: سمّيتُه مُحمّداً، فأقبل بخدِّه نحو الأرض وهو يقول: مُحمّد مُحمّد مُحمّد، حتّى كاد يُلصِق خدَّه بالأرض، ثُمَّ قال: بنفسي وبولدي وبأُمّي وبأبويَّ وبأهلِ الأرضِ كُلِّهم جميعاً الفداء لرسول الله|، لا تسبّه ولا تضربه ولا تُسيء إليه، واعلم أنّه ليس في الأرض دارٌ فيها اسْمُ مُحمّدٍ إلّا وهيَ تُقدّسُ كُلَّ يوم»[294].
4ـ حُبُّ مَن أحبّه| من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار وعداوة مَن عاداهم، وبغض مَن أبغضهم وسبّهم، فمَن أحبَّ شيئاً أحبّ مَن يحبّ، وقد قال| في الحسن والحسين «اللهمَّ إنّي أحبّهما فأحبّهما»[295].
وهكذا بالنسبة لأمير المؤمنين×. حيث قال| في حقّه: «مَن أحبّ عليّاً فقد أحبّني... ومَن أبغض عليّاً فقد أبغضني»[296].
وعن ابن عبّاس عن رسول الله’ أنّه قال: «مَن أحبّ عليّاً فقد أحبّني، ومَن أحبّني فقد أحبَّ الله، ومَن أحبّ أهل بيتي فقد استمسك بالعروة الوثقى الّتي لا انفصام لها»[297].
5ـ العمل بأوامره واجتناب نواهيه|: من علامات محبّته| العمل بأوامره والاجتناب عن نواهيه، وفي قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾[298] إشارة إلى الحبّ والطاعة، لا الحبّ المفرّغ من محتواه وأصله.
الأمر الثاني: حبّ أهل بيته ^
ثُمَّ إنَّ الأمر الثّاني في الحديث المرويّ عن النبي| يؤكّد على تأديب الآباء للأولاد على محبّة أهل بيته|.
وقبل الخوض في هذا الأمر أودُّ أن أُشير إلى سبب فصل هذا الأمر عن الأمر الأول.
فأقول: لماذا أكّد النبيّ| على محبّة أهل بيته مع أنَّ في محبته الكفاية لحبّ أهل البيت^، خُصوصاً بعد اطّلاعك على جُملةٍ من الأحاديث الّتي تربط بين محبّته ومحبّتهم^؟
وفي الجواب: إنَّ السّبب يعود إلى أنّ الملازمة حاصلة قطعاً من الأمر الثّاني، بمعنى أنّ مَن أحبَّ أهل البيت^ قطعاً فقد أحبّ النبيَّ الأكرم|؛ لأنّهم فرعه وثمرة غرسه، دون العكس، فقد يُربّي الأب أولاده على محبّة المصطفى| من دون أن يُعرّفهم أولادَه وذريتَه وأهلَ بيته؛ وحينئذٍ ينشأ الولد بمعزِلٍ عن أهل بيتِ المُصطفى|، كما يدلُّ عليه حال جُملةٍ ممَّن يدّعون الإخلاص في محبّتِهم للنبيّ ولم يتعرّضوا لذكرِ أهل بيته أصلاً، حتّى على مستوى الصّلاة عليهم، كما يصنعه بعضُ الجهلة من أعداء شيعةِ أهلِ البيتِ^، مع أنَّ الأخبار صريحة بإلحاق أهل البيت^ في الصّلاة على النبيِّ الأكرم|.
والعجب ممّن يدّعي الإسلامَ كيف يردُّ على كلامِ خاتمِ الأنبياء والمرسلين صريحاً؟ فقد نُقل أنَّ بعضَهم قال: إنَّ الصّلاةَ على مُحمّدٍ وآلِ مُحمّدٍ وإن ثبتت بالنصّ مُنضمّةً إلى النبيّ| إلّا أنّ الرّافضة (أي الشّيعة) لمّا اتّخذته شعاراً نتركه!!.
بل وصل الحال ببعضهم أن يقول: اللهمَّ صلِّ على مُحمّدٍ منفرداً. ويقيّدها بالانفراد!!
وكأنَّ آلَ مُحمّدٍ أنعموا وقدّموا للشّيعة فقط، ولم يُجاهدوا في سبيل نصرة الدين الإسلامي الحنيف؟!
فلعلّ مردّ هذا التأكيد إلى ما ذكرناه من أنّ مجرّد تأديب الأولاد على مَحبَّةِ المُصطفى| ليس صريحاً في الملازمة بمحبّة أهل بيته^. نعم، المفروض أن يكون ذلك كما ذكرناه في النقطة الرابعة من علاماتِ المُحبّين له| لكن الملازمة على أيةِ حالٍ ليست واضحةً وصريحةً.
أمّا من الطرف الآخر فنجد أنَّ النبيَّ الأكرم| يؤكّد على حصول الملازمة، كما روي ذلك في حقّ الإمام أمير المؤمنين× وفاطمة الزهراء‘، والحسن والحسين÷.
مثل قوله|: «مَن أحبّ عليّاً فقد أحبّني» المتقدِّم، ومثلُ وقوله| في حقّ فاطمة الزهراء‘: «فاطمة بضعة منّي فمَن أغضبها أغضبني»[299]، إلى غير ذلك من الأحاديث المرويّة عنه| وقد تقدّمت الإشارة إلى بعضها.
ولذا تراه| قد جمع بين التأديب على حُبّه وحبّ أهل بيته، ولعلّ ما في الحديث المروي عنه| كفاية حيثُ قال: «حبّي وحبّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهنّ عظيمة: عند الوفاة، وفي القبر، وعند النشور، وعند الكتاب، وعند الحساب، وعند الميزان، وعند الصّراط»[300].
فقد رتّب النبيُّ الأكرم’ الإشارة والنتائج على مجموع الحبّين (حبّه وحبّ أهل بيته’). فلاحظ جيّداً.
الأمر الثّالث: قراءة القرآن
والأمر الثّالث الّذي ينبغي لنا أن نؤدّب أولادنا عليه هو قراءة القرآن الكريم، ولا نحتاج إلى المزيد لمعرفة أهمّية هذا الأمر بعد أنْ يعلّل النبيّ الأكرم هذا الأمر بقوله’: بأنَّ حمَلَة القرآن ومفاهيمه والمهتمّين به هم في ظلّ الله يوم القيامة، في ذلك الظل وتلك العناية الفريدة، الّتي تمتدّ على الأنبياء والأولياء دون غيرهم من بني البشر، فإنّ هؤلاء الأنبياء الّذين يتأدّبون بهذه الآداب، ستشملهم تلك العنايات الربّانية لا محالة، وسينتهي بهم الأمر إلى كلّ خير. وإذا مات الوالد وهو على هذه الحالة ـ حالة تأديبه لأولاده على هذه الخصال ـ مات ولم ينقطع عمله ولا أمله؛ لأنَّه ترك صدقةً جاريةً، وعلماً ينتفع به ويهتدى بهداه، وولداً صالحاً يدعو له[301].
إذن التربية والتأديب هي الّتي تُنتج الولد الصّالح؛ ولذا نرى تربية أهل البيت^ ماذا أنتجت من نتاج ظلَّت مضرباً للمثل على مرّ العصور والدّهور، أمثال القاسم بن الإمام الحسن المجتبى ريحانة المصطفى| الّذي كان موصوفاً بالحُسن والجمال، لم يبلُغ الحُلُم، ووصفه الرّاوي حميد بن مسلم: بأنّه كفلقة قمر. وقد أكمل أربع عشرة سنة، حيث كانت ولادته سنة (46ﻫ) وقد أوصى أباه الإمام الحسن× به عمُّه الحُسين وصيةً خاصّة، ولذا كان الإمام الحُسين يخاطبه بقوله: أنتَ الوديعة من أخي. و كان القاسم صغيراً من حيث السّن إلّا أنّه كان كبيراً في عقله وهمومه؛ لأنّ أباه الحسن المجتبى× أدّبه وربّاه في صغره، فاستفاد من ذلك في كبره، ونشأ بين أحضان النبوّةِ والإمامِة، فلذا دلّت الدلائل على أنّه يملك أعلى مراتب الشّجاعة؛ ولذا لمّا رأى وحدة عمّه الحسين× وقف قائلاً: والله يا عمّ، لا أقدرُ أن أسمَعك تُنادي: ألا مِن ناصرٍ ينصرُنا. وأنا قابع في الخيمة، يا عمّ، ائذن لي، لقد ضاق صدري، وسئمتُ الحياة! فقال له الحسين×: يا بن الأخ، أنت الوديعة عندي من أخي الحسن، فارجع بُني وعد إلى الخيمة لتكون مع النساء فليس لهُنَّ أحد إلّا العليل، فابقَ معه لتؤنسه بعد فراقنا. فرجع إلى الخيمة، وهكذا جاء القاسم مرّة أُخرى، فقال له الإمام الحسين×: أوَ عَزمتَ على الموت يا بُنَّي؟ قال القاسم: نعم يا عمّ. قال الحسين له: إذهب إلى عمّتك زينب لتخرج لك من الصندوق جُبّة وعمامة وسيفَ والدك الحسنِ لتلبسها. وفعلاً أخرجت له زينب جُبّةً للإمام الحسن× فلبسها، ثمَّ عمامته وسيفه وحزامه، ثمَّ خرج من الخيمة وهو بلباس والده الحسن×. وكأنّي بالحسين× لمّا رآه بهذه الهيئة أهوى عليه وتعانق معه.
آه:
|
بس شافه شبگ فوگه اوتباچوا |
ثُمَّ خرجَ على الأعداء وهو راجل غير فارس، وكأنّه أبوه الحسن المجتبى×، فأخذ يرتجز ويقول:
|
إن تنكروني فأنا نجلُ الحَسن |
وكان الحسين× مُستبشراً بصوته وشجاعته، حيث أخذ يحصد بالرؤوس، ويفرّ منه الجيش على صغر سنّه، وعين الحسين تلاحقه ويشاهده ماذا يصنع بأعداء الله:
|
أبد والله ما تگف دون الفحل |
فأخذ يقتل فيهم حتّى قتل مقتلةً عظيمةً، ذكر بعضٌ أنّها وصلت إلى المائتين، وكان همّه أن يقتلَ صاحبَ راية جيش عُمر بن سعد، بينما هو كذلك يقول حميد بن مسلم إذ انقطع شسع نعله لا أنسى أنّها اليسرى، فطأطأ رأسَه لشدّها وإذا بالأزدي ـ لعنه الله ـ شدّ عليه وقال: لأثكلنّ به أُمّه، يقول حميد بن مسلم: فقلت له: أما كفاكم ما قتلتم؟ قال: والله، لأثكلنّ به عمّه وأُمّه:[302]
|
ويل گلبي من انگطع شسع النعل |
بالفعل ضرب الأزدي القاسم على رأسه فوقع على الأرض، وصاح: أدركني يا عمّاه! فقال الحسين× للقاسم: بُني قاسم، بُعداً لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدّك رسول الله. وكأنّي به:
|
صاح يا جاسم اوعِد راسه گعد |
وكأنّي بها:
(بحراني)
رملة اطلعت تلطم صدرها بدمع همّال
تنادي يغصن البان عنّي گوّض وشال
ظلّيت حُرمة بلا ولي من غير رجّال
وصارت الصيحة في خدور الهاشمية
وصلت لعد قاسم اومنها الگلب مهموم
صاحت ييمّه يا شباب المات محروم
مرمي على الرمضة ومتخضّب بالدموم
لبچي على فرگاك كل صبح ومسيّة
جلست عند رأسه، كأنّي بها تقول:
|
وحيّد وأعزّ عندي من العذيبي |
***
(أبو ذية)
|
يبني الدوم أباريلك وداري |
***
|
بُنيَّ في لوعةٍ خلّفتَ والدةً |
المحاضرة السابعة عشرة: التفقّه في الدين
|
قسمَ الإله الرّزء بين أعاظِمِ |
وكأنّي بأُمّهِ المفجوعة رملة:
|
آيبني شگول عليك آيبني |
(أبوذية)
|
يبني ما ذكرت أُمّك وحنّيت |
عن الإمام أبي جعفر الباقر× قال: «لو أُتيتُ بِشابٍ من شباب الشّيعة لا يتفقَّه في الدّينِ لأوجعته»[306].
في هذه الليلة نتحدَّث عن مسألةٍ مُهّمةٍ وهي مسألةُ التفقّه في الدّين!
ومعنى التفقّه هو أن يكون الإنسان على بصيرةٍ من الأمر الذي يطلبه، وهذا الأمر تارةً يكون في الدين وأُخرى في غير الدين، لكن المطلوب في هذه الليلة هو الكلام عن التفقّه في الدِّين. ولا يخفى أنَّ طلب العلم بصورةٍ عامّة هو من الأُمور المحبوبة في الدّين الإسلامي، ومن الأُمور الّتي رغّب الله فيها في أكثر من آية، قال تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾[307].
وقد حثَّ النبيّ الأكرم| عليها حيث قال: «لا خير في العيش إلّا لرجلين: عالم مُطاع، أو مستمع واعٍ»[308].
والعلم المُهم هو أن يقف الإنسان على معالم دينه وأحكام الشّريعة، خاصّة المتعلّقة بأحكام الحلال والحرام، فإنّ الروايات الّتي أكّدت على طلب العلم، وأنّه فريضة، ناظرة إلى هذا النحو من العلوم لا مُطلق العلوم، كما روي عن إمامِنا الكاظم×: «دخل رسولُ’ المسجدَ فإذا جماعة قد أطافوا برجُلٍ فقال ما هذا؟ فقيل: علّامة، فقال: وما العلّامة؟ فقالوا: أعلمُ الناس بأنساب العرب ووقائعها، وأيّام الجاهلية، والأشعار العربية.
قال: فقال النبيُّ’: ذاك عِلم لا يضرّ مَن جهله، ولا ينفع مَن عَلمه، ثُمَّ قال النبيّ’: إنّما العِلمُ ثلاثة: آية مُحكمة، أو فريضةٌ عادلةٌ، أو سُنّةٌ قائمةٌ، وما خلاهنَّ فهو فضل»[309].
وهذا الحديث ليس مختصّاً بالشباب الشّيعي ولكن الشابّ هو المهم في التَعلُّم، يعني: لا بدَّ للشابّ أن يتعلّمَ أحكام دينه حتّى يَعرف ما هو الحلال وما هو الحرام. يعني فالإمام× يتأذّى مِنْ أن يرى شابّاً شيعيّاً غير متفقّه في الدّين، ولذلك يقول الإمام× لأوجعتُه.
وهذه الليلة هي ليلةُ الشّباب، ليلةُ القاسم بن الإمام المجتبى×، فدعونا نستفيد من هذه الليلة، دعونا نستفيد من أخلاق أهل البيت^ في أيّام عاشوراء، دعونا نُفكّر فيكم يا شباب من حين البُلوغ إلى آخر عمركم كيف تبنون حياتَكم؟ كيف تختارون زوجات صالحاتٍ؟ كيف تتعاملون مع الزوجة؟ كيف تتعاملون مع الأبوين؟ ما هي عقوبة العاقّ لوالديه؟
نستفيدُ من هذه اللّيلة لنتعلّم كيف نُربّي أَنفُسَنا ونتخلّقَ بأخلاق القاسم×؛ لأنّه من هذا النسل الطّاهر.
نرجع إلى الرواية الشّريفة، لماذا الإمام× شدّد على تعلُّم الفقه؟ ولم يُشدد على غيره؟ لعلّه لأجل أنَّ الإنسان إنّما يُحاسَب في يوم القيامة على الأحكام الشّرعية، فلا بُدَّ للشّباب أن يسألوا عن أحكامهم الشّرعية في كلّ تصرفٍ يتصرفونه حتّى ينجوا من ذلك اليوم، يوم لا ينفع فيهِ مالٌ ولا بنونَ، إلّا مَن أتى الله بقلبٍ سليمٍ.
فعليكم يا شباب أن تُرتبوا حياتَكم من أوّلها، أي من حين البلوغ، فإذا بلغ الإنسان سنَّ التكليف ـ الَّذي يكون في المرأة بإكمال تسع سنوات وفي الرجل خمس عشرة سنة قمرية، أو الاحتلام ـ بعد ذلك لا بُدَّ له من التقليد والتوجّه إلى رسالة ذلك المجتهد الّذي قلَّده، وعليه أن يسأل عن المقلَّد، لأنَّ للمقلَّد شروطاً لا بُدَّ من توفّرها، فعليه أن يسأل العالم في تلك المنطقة عن العالِم المجتهد الّذي يريدُ تقليده؛ لأنَّ العمل بلا تقليد باطل، والعمل بلا عِلم لا يزيد العامل إلّا بعداً عن الطّريق[310]، ولذلك قليل العبادة مع العلم خيرٌ من كثيرها بِلا عِلمٍ[311]، فما الفائدة من عمل إنسانٍ يُصلّي في اليوم والليلة ألفَ ركعةٍ وهو لا يُتقنُ الوضوء، فعلى كُلِّ إنسان مراجعة فتوى المرجع الّذي يُقلّده حتّى يعرف الحلال من الحرام.
ومن أهمّ هذهِ الأُمور الّتي نتحدّث عنها الليلة هي مسألة طاعة الوالدين وبرَّهما حَيّين أو مَيتين فإنَّ رضا الله في رضاهما، وسخطه في سخطهما، وهذه المسألة كثيراً ما يتعرّض لها الشابّ في أوّل شبابه؛ لأنّه يرى نفَسه قد اكتمل ولا أحدَ يفيده في أيِّ رأيٍّ، ويرى أنَّ أبويه متخلّفان لم يطّلعا على العالَم الحديث، لم يطّلعا على عصر الأنترنيت، لم يطّلعا على الفنّ الغربي وعلى اللباس الغربي، فيعتبرون كلام الأبوين لغواً، وهذهِ هي الفادحة الكبرى، فعليكم ببرِّ الوالدين والطاعة لهُما حَيّين كانا أو مَيتين؛ لأنّ الله تعالى أمرنا بذلك في قوله:﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾[312]فإنَّ أوّلَ درجةٍ مطلوبةٍ مِن الإنسان هي توحيد الله وعبادته، ثُمَّ الإحسان للوالدين.
يجب أن لا تتضايق من الأبّ والأمّ إذا صارا شيخين كبيرين، تذكّر حينما كُنت طِفلاً وهما يخدمانك بكُلِّ أنواع الخدمة، ويتمنيان بقاءك، انظروا إلى الإسلام كيف يربط الأُسرةَ الواحدة برباط المودّة، برابط التّحابب، إن كان لأحدٍ حقٌّ على الولد بعد الله فهو للوالدين، وإنْ كان الله هو خالق الولد فإنّ الأبوين هما مُظهِرا ذلك الخلق.
رُوي عن عمّار بن حيّان قال: خبّرتُ أبا عبد الله× ببرِّ إسماعيل ابني بي، فقال: «لقد كُنتُ أحبُّه وقد ازددت له حُبّاً، إنّ رسول الله| أتته اُختٌ له من الرضاعة، فلمَّا نظر إليها سُرَّ بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثمَّ أقبل يُحدّثها ويضحك في وجهها، ثُمَّ قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله، صنعت بأُختِه ما لم تصنع به وهو رجلٌ؟! فقال: لأنّها كانت أبرَّ بوالديها منه»[313]، فالطاعةَ الطاعةَ للوالدين في الدُنيا، وبرّهما فيها، وكذلك برّهما وهما مَيتين بعدّة أُمورٍ، منها:
1 ـ أنْ يُصلّي صلاة برّ الوالدين، وهي: ركعتان، يقول في الأُولى بعد الحمد عشر مرّات: (ربِّ اغفر لي ولوالديّ وللمؤمنين يومَ يقوم الحساب)، وفي الثانية بعد الحمد عشر مرّات: (ربِّ اغفر لي ولوالديّ ولمَن دخل بيتي مؤمِناً وللمؤمنين والمؤمنات)، ويقول بعد التسليم والانتهاء من صلاته: (ربِّ أرحمهما كما ربيّاني صَغيراً) عشر مرات[314].
2 ـ أن يتصدّقَ عنهما.
3 ـ أن يقضي ما فاتهما من صلاةٍ وصيام وحجٍ إن تمكّن.
4 ـ أن يقضي ما عليهما من دُيونٍ.
5 ـ أن يزور المراقد الشّريفة عنهما، ويدعو لهما في تلك المراقد والمشاهِد الشريفة، وفي صلاة الليل، وصلاة الجُمعة.
فإنْ عَمِلَ ذلك فقد فتح على نفسه أبوابَ الرّحمة والسعادة في الدّارين، وخُتمت أعمالُه بحُسن العاقبة إن شاء الله تعالى، وذلك غاية الغايات.
ثُمَّ إنَّ ما تقدّم من الكلام في برّ الوالدين بصورةٍ عامّة، ولكن هُناك خصوصية للأُمّ، فعن أبي عبد الله×، عن رسول الله’ قال: «جاء رَجُل إلى النبيّ’ فقال: يا رسولَ الله، مَن أبرُّ؟ قال: أُمَّكَ. قال: ثُمَّ مَن؟ قال: أُمَّك. قال: ثُمَّ مَن؟ قال: أُمَّك. قال: ثُمَّ مَن؟ قال: أباك»[315]. ثلاث مرات يكرّر النبيُّ’ البرّ بالوالدة؛ لأنَّ الأُمّ هي التي حملتك وربتك، وجاعت وأشبعتك، وسهرت من أجلك الليالي والأيّام، قال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾[316]، وقال تعالى: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾[317]، وهذه اللّيلة هي ليلة شاب من الشّباب المتفقّه في الدّين، الّذي يلزم على الشّباب أن يقتدوا بهِ، فلقد كان عارفاً بأحكام الدّين، وبارّاً بوالدتهِ وكيف لا؟! فهو تربّى في حضن الإسلام، ورضع من ثدي الإيمان، فهكذا كان. ولو فكّر الإنسان إلى ما لاقاه القاسم يوم كربلاء لَعرف بسالتَه وشجاعتَه تجاه العدوّ، لمّا حمل على القوم وجعل يضربهم بسيفه، فهذه أفعاله يوم الطفّ، وأمّا أقواله فتبهر العقول؛ وذلك لمّا ارتجز وهو في الميدان غايتُه أن يعرَّفهم نفسه، بل مُفتخِراً بقوله:
|
إن تنكروني فأنا نجلُ الحَسن |
وكانت هِمّتُه أن يقتُل حامل رايةَ عُمر بن سعد، فبينما هو يُقاتلُ إذ انقطع شسع نعله اليُسرى فوقف ليشدَّها، فقال عمرو بن سعيد بن نفيل الأزدي: والله، لأشدّنَّ عليه وأثْكلنَّ به أُمَّه. فقال له حميد بن مسلم: وما تريد بذلك؟ والله،ِ لو ضربني ما بسطتُ يدي، يكفيك هؤلاء الّذين تراهم قد احتوشوه من كلّ جانبٍ. قال: والله، لأفعلنَّ. فشدَّ على الغُلام فما ولّى حتّى ضربَ الغُلام بالسّيفِ على رأسه، فوقع القاسم لوجهه وصاح: أدركني يا عمّاه، فأتاه الحُسينُ وإذا بالغلام يفحص بيديه ورجليه، فقال: «عزَّ والله على عَمّكَ أن تدعوه فلا يُجيبك، أو يُجيبك فلا يُعينك، أو يُعينك فلا يُغني عنك، بُعداً لِقومٍ قتلوك، ومَن خصمهم يومَ القيامة جدُّك وأَبوك، هذا يوم والله كثر واتره وقلَّ ناصرُه»[318].
(نصّاري)
|
بچه وناداه يا جاسم اشبيدي |
ثمَّ حمله على صدره ورِجلاه يخطّان في الأرض، حتّى جاء به إلى المخيّم، ووضعه إلى جنب ولده عليِّ الأكبر، وهو يقول: يا ابن أخي، أنت الوديعة.
(دكسن)
|
جابه ومدده ما بين اخوته |
***
كأنّي بالحسين× لمّا جاء بالقاسم إلى الخيمة الّتي فيها عليٌّ الأكبر وطرحه إلى جنبه، جعل ينظر إلى وجه الأكبر تارةً، وإلى وجه القاسم تارةً أُخرى، وهو يكفّكفُ دمُوعَه بكُمِّه، وكانت أُمُّ الأكبر وأُمُّ القاسم تنتظران خروجَه؛ لأنّهما لا تستطيعان أمامَ الحُسين× أن يندبن ولديهما وهو حاضر، لِذلك جئن إلى زينب وطلبن مِنها أن تذهب وتطلُب من الحُسين× أن يفسح لهُنَّ المجال؛ ليقضين وطراً من البكاء على الشّباب، كأنّي بها‘ جاءت إلى الحسين× قائلةً: أخي أبا عبدالله، ساعدك الله على هذهِ المصيبة، أبا عبد الله هذهِ أُمُّ القاسم وأُمُّ عليٍّ الأكبر يُردن الدخول للبكاء على قتلاهُنَّ، وهُن يستحين مِنك، فقال الحُسين×: إنّ المصيبة والرزء أكبر فليأتين وليندبن قتلاهُنَّ، عِند ذلك إلتفتت الحوراء زينب وصاحت يا ليلى، ويا رملة، هَلُمْنَ للبُكاء والعويل، جئن فدخلن عليها بعد ما خرج الحُسين× من الخيمة:
(نصّاري)
|
طبن من طلع من خيمته احسين |
ولسان حال أُمّه:
|
يبني العتب وياك شيفيد |
ماذا تريد كأنّي بها تجيبُ قائلةً:
(أبوذية)
|
ردتك ما ردت دنيا ولا مال |
(تخميس)
|
رزءٌ تكاد السّما تهوى لمصـرعه |
فما بـكى قـمـرٌ إلّا عـلى قـمـرِ
المحاضرة الثامنة عشرة: حقّ الأب
|
يَا نيّراً فيهِ تُجلى ظُلمَةُ الغَسَقِ |
(بحراني)
من وگع شبه المُصطفى فوگ الوطيّة
ناده ابرفيع الصوت بويه الحگ عليّه
صوته وصل لحسين وحسين اعتناله
امن الخيم والمدمع دمه من العين ساله
اويمّه وگف لكن فلا ينوصف حاله
حين الوصل يمّه اوعاينله رميّة
دنگ اوشمّه اوظل يحل درعه اوطاسه
او يجذب الونّه اعليه وينادي بحماسه
تهدّم يبويه اليوم بنياني امن أساسه
اوشملي تفرّگ والصواب البيك بيّه
(نصاري)
|
يبويه لا تفت روحك عليه |
***
في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين× أنّه قال: «وَحقُّ أبِيكَ أنْ تَعلمَ أنّه أصلُك، وأنَّه لولاهُ لم تَكُنْ، فَمَهما رأيتَ في نَفسِكَ ما يُعجبُك فاعلم: أنَّ أباكَ أصلُ النّعمةِ عليكَ فيهِ، فاحمدِ الله واشكرهُ على قَدرِ ذَلِكَ، ولا قُوَّةَ إلّا بالله»[321].
لقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق، وسنّ لهم الأحكام والسُّنن، وجعل بينهم الرّوابط والأواصرَ والحقوق؛ ليتسنّى لهم العيش الرّغيد، والحياة الكريمة، والّتي لولا توفّر هذين العنصرين فيها لأصبحت جحيماً، ولصارت هي والموت على حدٍّ سواء، بل يكون الموت سعادة أحياناً، كما جاء على لسان سيّد الشُّهداء×: «فإنِّي لا أرى الموت إلّا سعادةً والحياةَ مع الظَّالمين إلّا بَرماً»[322]، وما جعل هذه الحياة بهذا الشكل إلّا خلوّها من النّاس الطّيبين الّذين يحترمون حُقوقَ الآخرين.
وبما أنَّ المجتمع الإنساني ليس إلّا عبارة عن مجموعةٍ من الأفراد تُسمّى كُلّ حلقة من هذه المجاميع بالأُسرة، شرّع الله تبارك وتعالى الحقوق بين أفراد الأُسرة الواحدة والمتمثّلة بالأبوين والأولاد، والّتي بدورها تحفظ لنا العائلة الواحدة وبالتّالي سوف نحفظ مجتمعاً كاملاً. هذه التعاليم القيّمة وصلت لنا عن طريق القرآن الكريم والسنّة المطهّرة، وبهذين الثَّقْلين العظيمين أصبحنا على اطّلاع كاملٍ على المنهج الحقيقي لحفظ قوام هذه الأُسرة. فجاءت الآيات والروايات تترا، ففاز قوم باتّباعها، وخسر آخرون بهجرانها.
ومن هذه الحقوق التي وصلت إلينا من السّنة المطهرة وثيقة هي أعظم لائحة حقوق وأجمعها، ألا وهي رسالة الحقوق للإمام زين العابدين وسيّد السّاجدين×، والّتي ذكر فيها العشرات من الحقوق، الّتي تصلح أن تكون دستوراً للعالم بأسره. اخترت في هذا المحاضرة المقطع المتعلّق بحقّ الآباء على الأبناء لمناسبته لهذه الليلة العظيمة.
حقوق الآباء على الأبناء
إنَّ الله تبارك وتعالى جعل لنا الأسباب حتّى نوجَد بعد أن كُنّا معدومين، وأقرب تلك الأسباب الملموسة الأبوان، ولكلِّ واحدٍ منهما حقوق وواجبات أشار لها القرآن الكريم والسُّنّة المطهّرة، وقد لخّص لنا الإمام زين العابدين× هذه الحقوق، ونحن نتناول الحقَّ المتعلّق بالآباء الّذي يجب على الأبناء الوفاء به والالتزام بحدّه، حيث قال الإمام×: «وحقّ أبِيكَ أن تعلم أنّه أصلُك» وهذه الكلمة المختصرة غاية في الرّوعة والجمال؛ إذ ما من شيءٍ يصيبك من الخير إلّا والأصل فيه أبوك؛ لأنّه أوجدك، فلا بدَّ أن تستشعر دائماً هذا المعنى، وتفتخر به كما كانت العرب يفتخرون بآبائهم في أسواقهم وفي موسم الحجّ؛ حتّى قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾[323].
فالولد بضعة من أبيه يرث بعض صفاته وطباعه وشمائله، من جسديّة ونفسيّة وعقليّة، فالأبّ هو الأصل، والأبناء هم الفرع لذلك الأصل، فلا بدَّ من حفظِ ذلك له وتقدير تلك الآهات والحسرات الّتي قضاها الأب في سبيل أبنائه والّتي جعلت إمامَنا زينَ العابدين× أيضاً يقول في دعائه في الصّحيفة السجّادية: «اللهمَّ اجعلني أهابَهما هيبةَ السُّلطان العَسوف، وأبرَّهُما برَّ الأُمِّ الرؤوف، واجعل طاعتي لوالديَّ وبرّي بهما أقرَّ لعيني من رَقِدة الوَسنان، وأثلج لصدري من شربةِ الظمآن»[324].
ولمّا كان الأبناء فرعاً لذلك الأصل قال النبي الأكرم’ لذلك الولد الممتنع عن النفقة من ماله على أبيه: «أنتَ ومالُك لأبِيك»[325]، ولم يقبل النبيّ الأكرم’ أيَّ عمليةِ التواءٍ أو امتناع عن تأديته الحقّ لأبيه.
ولأنقل لكم هذه القصّة الّتي يُعرف منها كلّ تلك المعاني.
روى العلّامة المجلسي& في البحار: «إنّ شيخاً كبيراً جاء بابنه إلى رسول الله’ والشّيخ يبكي ويقول: يا رسول الله، ابني هذا غذوته صغيراً، وربيته طفلاً عزيزاً، وأعنته بمالي كثيراً حتّى اشتدّ أزره، وقويَ ظهرُه، وكثرُ مالُه، وفَنيت قوّتي وذهب مالي عليه، وصرت من الضّعف إلى ما ترى، فلا يواسيني بالقوت المُمسك لرمقي. فقال رسول الله’ للشّاب: ماذا تقول؟ قال: يا رسول الله، لا فضل معيَ عن قوتي وقوت عيالي. فقال رسول الله للوالد: ما تقول؟ فقال: يا رسول الله، إنَّ له أنابير[326] حنطة وشعير وتمر وزبيب، وبدر[327] الدّراهم والدّنانير وهو غنيٌّ. فقال رسول الله للابن: ما تقول؟ قال الابن: يا رسول الله، ما ليّ شيء ممّا قال. فقال رسول الله’: اتّقِ الله يا فتى، وأحسن إلى والدك المحسن إليك. قال: لا شيء لي. قال رسول الله: فنحن نعطيه عنكَ في هذا الشهر، فأعطه أنت فيما بعد، وقال لأُسامة: أعطِ الشّيخ مائة درهم نفقةً لشهره لنفسه ولعياله. ففعل، فلمّا كان رأس الشّهر جاء الشيخ والغلام، وقال الغُلام: لا شيء لي. فقال رسول الله: لك مال كثير، ولكنّك اليوم تُمسي وأنت فقير، وتصير أفقر من أبيك هذا لا شيءَ لك. فانصرف الشّاب فإذا جيران أنابيره قد اجتمعوا عليه يقولون: حوّل هذه الأنابير عنّا، فجاء إلى أنابيره وإذا الحنطة والشعير والتمر والزبيب قد نتن جميعُه، وفسد وهلك، وأخذوه بتحويل ذلك عن جوارهم، واكتراء أُجَراء بأموالٍ كثيرة، فحوّلوه وأخرجوه بعيداً عن المدينة، ثُمَّ ذهب يخرج إليهم كراءً من أكياسه الّتي فيها دراهمُه ودنانُيره، فإذا هي قد طمست ومسخت حِجارةً، وأخذ الحمّالون يطالبون بالأجرة، فباع ما كان له من كسوةٍ وفرشٍ ودارٍ وأعطاهم الكراء، وخرج من ذلك كلّه، صفراً ثُمَّ بقي فقيراً وقيراً[328] لا يهتدي إلى قوت يومه، فسقم لذلك جسده وقضى، فقال رسول الله’: يا أيُّها العاقّون للآباء والأُمّهات اعتبروا واعلموا أنّه كما طمس في الدنيا على أمواله، فكذلك جعل بدل ما كان أعدّ له في الجنّة من الدّرجات مُعدّاً له في النّار من الدركات...»[329].
فمن هنا وجب على الولد نحو أبيه وأُمّه أُمور أربعة[330] : (الحُبّ، الشُّكر، الطّاعة، الاحترام)
1ـ أمّا الحُبّ: فعاطفة فطريّة أوجدتها القدرة الربانيّة في قلب الولد، وكلّما نما الولد ازداد إدراكُه وشعوره بالمحبّة، وإن كانت لا تصل إلى الحدّ الّذي عليه الوالدان ـ وبالخصوص الأُمّ ـ ومن هنا نعرف اهتمامَ القُرآن الكريم والسُّنّة المطهّرة بعدم عقوق الوالدين، والحبّ لهما حتّى قُرِنا بالتوحيد وعدم الشّرك، ولم يأتِ في القُرآن الكريم ذلك الحثّ من الأبوين تجاه الأولاد لكون فطرة حبّ الآباء للأبناء قويّة إلى درجةٍ لا يحتاجون إلى توصيةٍ بهذه المثابة، كما روي ذلك في قصّة الشابّ الّذي كان يلي من والديه ما يليان منه عند الصّغر من الفضلات، فإنَّ النبيَّ الأعظم’ بيّنَ للشابّ أنَّ الفرق هو: «أنّهما كانا يليان مِنكَ ذلك وهما يُحبّان بقاءَك، وأنت تفعل ذلك ولا تُحبّ بقاءَهما»[331]، فالفطرة كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة، بخلاف الولد فإنّه بحاجةٍ إلى الوصيّة المكرّرة.
2ـ وأمّا الشّكر لهما: أي للوالدين، فيجب أن لا يحدّه حدّ، ولا يُحصيه عدّ؛ لأنّهما سبب الولد في الحياة الدنيا، وهما اللذان ربّياه وأحبّاه حُبّاً جمّاً، واشتغلا من أجله، وكابدا الآلام في سبيل راحته، وسهرا على حياته، وأقلّ ثمن لذلك الشّكر، وعليه أن يقرن هذا الشُّكر بالعمل لنفعهما، وتخفيف أعباء الحياة عنهما، فهو عدتهما في الحياة، وفلذة كبدهما، وموضع هنائهما، ومحلّ عنايتهما.
3ـ وأمّا الطّاعة لهما: أي للوالدين، فهي دليل على إخلاص الولد وحبّه، فواجٌب عليه أن يُطيعَهما، وأن يخلص لهما في السرّ والعلانية، وأن يعمل بنصائحهما، وأن يعتقد كُلَّ الاعتقاد أنَّ الفوز والنجاح في امتثال أوامرهما، والخيبة والخسران في مخالفتهما؛ لأنّهما أعرف منه بالنفع والضرّ، وأكثر خبرة منه بأُمور الدنيا، ولا يهمّهما إلّا نفعُه وراحتُه وسعادتُه.
4ـ وأمّا احترامه لهما: فيكون برعاية الأدب نحوهما في قوله وفعله، فلا يعاملهما مُعاملةَ الأنداد، بل معاملة الصّغير للكبير، حتى إذا بلغا من الكبر عِتيّاً وجب عليه احتمال ما يبدو منهما، مهما كان مخالفاً للعقل، والصّبر مع التلطّف في إرشادهما إلى جادة الحقّ والصّواب[332].
فإذا قام بهذه الأُمور الأربعة وأرضاهما صارت دعوتهما له لا عليه، فاستجاب الله لهما، فعن الإمام الصادق× أنّه قال: «ثلاث دَعَوات لا يُحجبن عن الله تعالى: دُعاء الوالد لولده إذا برّه، ودعوتُه عليه إذا عقّه، ودُعاء المظلوم على ظالمه...»[333].
لذا رجع عليّ الأكبر× في المرّة الأُولى بِدُعاء أُمِّه ليلى وهو يحمل رأس بكر بن غانم، وقد أسرّ والديه وقد دعا له أبوه الحسين×. ولم يكن دعاء للعودة والسّلامة بل دعاء لهلاك الأعداء، وذلك عندما رجع عليّ الأكبر من الميدان وهو يقول: أبتاه العطش قتلني، وثقل الحديد أبهضني، هل من شربة من الماء أتقوّى بها على قتال الأعداء، عندها ذرفت عينا الحسين بالدّموع، وقال له: بُنيّ عليّ أنا أيضاً مثلُك عطشان، بنيَّ اصبر وارجع إلى الميدان:
آه:
|
يصيح بصوت فت گلبي وشعبني |
ثُمّ إنّ الحسين× نظر لولده عليّ الأكبر نظر آيسٍ، وأرخى عينيه بالدّموع، وأطرق برأسه إلى الأرض؛ لئلّا يراه العدوّ فيشمت به، وقيل: إنَّ الإمام قال له: ولدي عليّ، إليّ إليّ أودّعُك وتودّعني، وأشمُّك وتشمّني، فاعتنق الحسين ولده وجعلا يبكيان حتّى وقعا على الأرض.
|
أويلي من تلاگو عند الوداع |
وجعل يُقاتل حتّى قتل تمامَ المائتين، قال حميد بن مسلم: كنت واقفاً وبجنبي مُرّة بن منقذ (العبدي)، وعليّ بن الحسين يشدّ على القوم ميمنة وميسرة فيهزمهم، فقال مُرّة: عليّ آثام العرب إن مرّ بي هذا الغلام ولم أثكل بهِ أباه. فلمّا مرّ وهو يطرد كتيبةً أمامه، فطعنه برُمحه فانقلب على قربوس فرسه، فحمله إلى مُعسكر الأعداء، وكانت الفرس من خيل جياد رسول الله’، إلّا أنّ وقوع الدم على عينها جعلها تسير بلا دراية نحو الأعداء.
أويلي:
|
عگب ما شرّگ الهامات والطاس |
وكان كلّ ظنّ عليّ الأكبر أنّ الجواد سار به نحو معسكر والده الحسين×:
|
شبگ على المهر لبّاله يوديه |
وعندما بلغت روحه التّراقي نادى: أبه، عليكَ منّي السّلام، هذا جدّي رسول الله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً، وهو يقول لك: العجلَ العجلَ فإنَّ لك كأساً مذخورة.
|
نده يحسين هذا السّاع جدّي |
تقول سكينة: لما سمع أبي صوت علي أخذ تارة يقوم وأُخرى يجلس وهو يقول: وا ولداه، ثُمَّ انحدر إليه الحسين× ومعه أهل بيته حتّى وقف عليه، رآه مُقطّعاً بالسيوف إرباً إرباً، آه:
|
گعد عنده اوشافه مغمّض العين |
قال أرباب المقاتل: ثُمَّ صاح الحسين: يا فتيان بني هاشم احملوا ولدي، والله لا طاقة لي على حمله، فجاؤوا إليه وحملوه إلى المخيّم والحسين ينادي: وا ولداه! بينما هم كذلك وإذا بعمّته زينب جاءت تنادي: يا حبيباه يا ثمرة فؤاداه! فجاءت حتّى انكبّت عليه وهي تشمُّه وتُقبّله.
|
هوت فوگه تشمّ خدّه اوتحبّه |
ثُمَّ جاءت أُمُّه ليلى لتُساعد عمَّته زينب على البكاء، فرأته مُقطّعاً بالسّيوف[335] إرباً إرباً، فنادت وا ولداه وا علياه! وكأنّي بها تنعاه:
|
فجيده يا علي يبني فجيده |
***
(تخميس)
|
لمصابه اظلمّ الصّباح وفجرُه |
المحاضرة التاسعة عشرة: حقّ الولد
|
بشبهِ المُصطفى جاؤوا قتيلاً |
(نصّاري)
|
گعد عنده وشافه
امغمّض العين |
(أبوذية)
|
گِظوا گومي وعمامي إزغار واكبار |
***
روي عن رسولِ الله’ أنّه قال: «من حقّ الولد على والده ثلاثة: يُحسنُ اسمه ويُعلّمه الكتابة، ويُزوّجه إذا بلغ»[337].
الله تبارك وتعالى عِندما خلق الخلق أوجب عليهم حقوقاً، وفرض لهم حقوقاً، فعندما نتحدّثُ عن برّ الوالدين ولا بُدَّ للولد أن يبرّ أبويه حيّين أو ميّتين، وفي بعض الروايات مُسلمَين أو كافرَين[338]، وليس معنى هذا أنّ الولد ليس له حقّ على والديه، بل إنّ الله تبارك وتعالى كما أوجب حقّ الوالدين على الأولاد كذلك أوجب حقَّ الأولاد على الوالدين، وأوصى كُلَّ واحدٍ مِنهما بالآخر رحمةً مِنه وحكمةً، إذ قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾[339] وغيرها من الآيات الشّريفة، وأكّد الرسولُ’ في أكثر من حديثٍ على مسألة التوادد من قِبل الأبوين بحقّ الولد، إذ قال’: «ريحُ الولد من ريح الجنّة»[340]، أو «إذا نظر الوالدُ إلى ولده فسرّه كان للوالدِ عِتق نَسَمة»[341].
ولا فرق في ذلك بين الذّكر والأنثى، بل إنّ بعضَ الروايات أكّدت على الاهتمام بالبنت أكثر من الولد؛ لأنَّها ضعيفة، فقد رُويَ أنّ رجلاً ولِد له جارية، فدخل على أبي عبد الله الصّادق× فرآه متسخّطاً، فقال له: «أرأيتَ لو أنّ الله أوحى إليك أن: أختار لك أو تختار لِنفسكَ؟ ما كنت تقول؟» قال: كُنتُ أقولُ: يا ربِّ تختار لي، قال: «فإنَّ الله} قد إختار لك»، ثُمَّ قال: «إنَّ الغُلام الَّذي قتله العالِم الَّذي كان مع موسى× وهو قول الله: ﴿ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا﴾[342] أبدلَهما الله بِه جاريةً ولدت سبعين نبيَّاً»[343]، بل إنَّ وجود البنت في البيت حسنة، «البنات حسناتٌ، والبنون نعمة، وإنَّما يُثاب على الحسنات ويُسأل عن النعمة» كما ورد هذا المعنى في أكثر من رواية[344]. وأبسط الأُمور الّتي تَجلب التوادد بين الأب والابن هي القُبلة، فرسول الله’ كان كثيرَ التقبيل لفاطمة والحسن والحُسين^[345]، والقُرآن يصدع ويقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾[346] أفلا نستَّن بسُنةِ الرسول الأكرم’ في هذه الأُمور وما أبسطها على الإنسان.
في يومٍ من الأيّام نظر أحد الصحابة إلى النبيّ’ وهو يقبّلُ الحسنَ والحُسين÷، فقال: إنَّ لي عشرةَ من الولد ما قبّلتُ أحداً مِنهم، فقال رسولُ الله’: «مَن لا يَرحَمُ لا يُرحمُ»[347] يعني القبلة للولد رحمة، ترحم نفسَك بها أيّها الوالد وأيّتُها الوالدة.
مِن بعد هذا البيان نأتي إلى الحقّوق التي تجب على الوالدين وبالأخصّ الأبّ لولده، فالحديث ذكر ثلاثةَ حقوق لأهمّيتها، وإلّا فهي أكثر من ذلك.
الحقُّ الأوّل: أن يُحسنَ الوالد تسميةَ ولدهِ، وهو حقُّ ليس صعباً، وفي نفس الوقت هو مُهمٌّ، عندنا في الروايات استحباب التسمية للحمل[348]، يعني الإنسان عندما يكون عِند زوجته حمل يُسمّيه باسمٍ حَسَنٍ كما ورد عن الإمام الكاظم×: «أوّل ما يبرُّ الرَجلُ ولدَه أن يُسمّيه باسمٍ حسنٍ، فليُحسنْ أحدُكم اسمَ ولده»[349].
وعن النبيِّ الأكرم’: «استحسنوا أسمائكم، فأنّكم تُدعون بها يومَ القيامة»[350].
وأهمّ وأجمل الأسماء هي أسماء مُحّمدٍ وآلِ مُحّمد (صلوات الله عليهم أجمعين) فهي أصدق الأسماء، وأحلى الأسماء، وكما جاء في الزيارة الجامعة: «فما أحلى أسماءكم»[351] وأفضلُ الأسماء اسم (مُحمّد)؛ لأنّ هذا الاسم هو اسمٌ لأشرفِ مخلوقٍ على الإطلاق، لا يُدانيه اسمٌ أبداً، حتّى إنّه ورد في الرواية عن النبيّ الأكرم’: «مَن ولد له أربعة أولاد لم يُسمِّ أحدهم باسمى فقد جفاني»[352]، وغير هذا الاسم الشّريف من الأسماء الّتي فيها عُبوديّة، كعبدِ الله وغيرها كما جاء في الرواية الشريفة «لا يدخلُ الفقرُ بيتاً فِيه إسم مُحمَّد أو أحمد أو عليّ، أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبد الله أو فاطمة من النساء»[353] وعلى الإنسان الشّيعي الموالي لأهل البيت^ أن يتجّنبَ عن أسماء أعدائهم؛ لأنّ التسمية بأسماء أعداء أهل البيت تُفرحُ الشيطان، كما جاء في الرواية الشّريفة عن الإمام الباقر×: «إنَّ الشيطان إذا سمع مُنادياً يُنادي يا مُحّمد، يا عليّ، ذاب كما يذوب الرصاص، حتى إذا سَمِع مُنادياً يُنادي باسمِ عدّوٍ من أعدائِنا اهتزَّ واختال»[354].
وفي الأثر أنّ امرأةً ـ بعد شهادة أميرالمؤمنين× ـ اشترت عبداً سمّته عبد الرّحمان وكانت تُكثِر نداءه، فقيل لها في ذلك، فقالت: إنّي كُلَّما طلبتُه تذكّرتُ قاتِل عليَّ بن أبي طالب فأفرح ويسكن ما بي من البُغض والحنق عليه[355].
الحقّ الثاني: وهو أن يُعلّمه الكتابة، وهذا أيضاً من الحقوق العظيمة جدّاً؛ لأنّ الكتابة تفتح الطّريقَ أمام هذا الطفل في المُستقبل لاستقبال المعارف الإلهيّة والقُرآن الكريم، وكم إنسانٍ حُرمَ من هذه النعمة الكبيرة، نِعمة القراءة الّتي تفتح له الآفاقَ للتفاهم مع النّاس، وقد أكّد الله تبارك وتعالى على التعلّم والعلم في أكثر من آيةٍ، حتّى أنّه أقسم في القرآن بالقلم، إذ قال تبارك وتعالى: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾[356]؛ لأنّ الإنسان بدون كتابة وقِراءة يكون فاقداً لوسيلة من وسائل التفاهم ليست عاديّة؛ لأنَّ الإنسانَ تارةً يحصل على العلوم عن طريق السّمع، وأُخرى عن طريق الرؤية، وثالثة عن طريق القراءة والكتابة.
فجدير بالإنسان ـ سواء كان والداً أم لا ـ أن يُتعب نفسه من أجل أن يُعلّم الولد الكِتابة والقراءة ويعلّمه القُرآن الكريم، وكلّ هذا فيه أجر وثواب للعالم وللمتعلّم حتّى جاء في الرواية الشّريفة عن أبي جعفر×: «إنَّ الذي يُعلّمُ العِلمَ منكم له أجر مثل أجر المتعلّم، وله الفضلُ عليه، فتعلّموا العلم من حَملةِ العلم، وعلّموه إخوانَكم كما علّمكموه العُلماء»[357] حتّى إنّ النبيَّ الأكرم’ في بداية الدّعوة الإسلامية كان يأتي للأسير من المشركين ويطلب منه أن يعلّم الكِتابة لعشرة من المُسلمين ثمّ يُطلق سراحه[358]؛ وماذاك إلّا لأهمّية أمر التعلّم.
الحقّ الثالث: وهو أن يُزوّجه إذا بلغ؛ لأنَّ الزواج عامل مُساعد للولد على التحصّن من الوقوع في المحرَّمات، ولا نقصد بالمُحرّمات هُنا هو الزنا والعياذ بالله فحسب، بل حتّى إنَّ النظرةَ إلى المرأة الأجنبية مع التلذّذ والريبة هي مُحرَّمة، وتوجب الزواج على هذا الولد، فكان على الأب أن يُزوّج ولده فيما إذا كان الولد يستحقّ الزواج، يعني: بلغ السن الكافي لأن يتحّمل مسؤولية زوجة وعِيال، لا أن يزوّجه وإذا بين يومٍ وليلةٍ يحصل الطلاق، فلا بدّ من الفحص والتدقيق في معرفة الزّوجة وعيال الزّوجة وأهم شيء فيها ـ على ما في الروايات[359] ـ هو: «أن تكون كريمة الأصل، عفيفة، ولود» يعني: من عائلة كريمة الأصل، وعائلة ملتزمة بأحكام الله سُبحانه وتعالى، وكذلك عادة عشيرتها الولادة، يعني: والدتها، جدتُّها، أخواتُها ليست فيهنَّ عقيم، وأن لا يقتصر على المال والجمال فقط، بل عليه أن يتفحّص جيداً عن هذه الصفات المتقدّمة، فإذا كان الولدُ غير مالك للمَهر والأب مالِكَ له فيجب على الأب أن يُزوّجَ ولده من ماله، وأمّا إذا كان الولد يملك المَهر فعليه أن يتزوّجَ بمهرٍ منه، لا من أبيه، لكن على الأب ألّا يقطع عن ولده السّعي في هذه المهمّة الخطرة والعظيمة، وأعظم أجر للإنسان أن يسعى في قضاء الحوائج، لا سيّما في الزواج، سواء للابن أو لغيره، وكذلك على الأب ألّا يغفل جانب البنت، فإنّها تحتاج الزوج؛ لأنَّ البنات كالثمر على الشّجر إذا حان وقته ولم يُقطع فسد[360]، فعلى الأب إذا بلغت البنت عنده أن يُربيّها تربيةً صالحة، ثُمَّ بعد ذلك يزوّجها من إنسانٍ مؤمنٍ.
وهذهِ الحقوق قد أدّاها الإمام الحُسين× وقام بها بحقٍّ لولده عليِّ الأكبر، إذ من حقّ الولد على والده أن يُحسن اسمه، وما أحلى وما أحسن اسمه؛ إذ سمّاه عليّاً كجدّهِ أميرِ المؤمنين×، وأن يُعلّمه الكِتابة، وكان عليّ الأكبر يحمل صفات النبيّ الأكرم’[361].
وكذلك أن يُزوّجه إذا بلغ، فكان عليُّ الأكبر مُتزوّجاً كما في الرواية الصّحيحة عن الإمام الصّادق× في زيارةٍ له علّمها أبا حمزة الثمالي قال: تضع خدَّك على القبر وتقول ثلاثاً «صلّى الله عليك يا أبا الحسن»، ثمّ يقول فيها: «صلَّى الله عليك وعلى عترتِك وأهل بيتِك وآبائِكَ وأبنائك وأُمهاتِك الأخيار»[362]، ولفظ الأبناء جمع يدلُّ على أكثر من اثنين، وأنّ له أهلاً وولداً وإن كان عقبه منقطع الآخر، فَكلُّ الصفات قد اجتمعت في هذا الإنسان العظيم والولد البار بوالديه، وكيف لا؟! وقد رضع من ثدي النُبوّة، وفي مَهدِ الإمامة ترعرع وتربّى، فهو ابنُ سيّد الشُهداء، ولذلك ِعِندما رأى عليُّ الأكبر أنَّ لا بُدَّ لهذا الدين من مُحامي جعل يطلب البراز، فلم يبرز إليه أحد هيبةً منه. هذا والإمام الحُسين× واقف بِباب الخيمة وليلى جالسة في خيمتها، تأخذ علامة السّلامة من وجه الحُسين×، جالسة تنظر في وجه الحُسين تراه يتلألأ نُوراً وسروراً بشجاعة ولده عليِّ الأكبر، فبينما هو كذلك وإذا بوجه الإمام قد تغيّر، قامت ليلى وقالت: سيّدي أبا عبد الله، أرى وجهَك قد تغيّر، فهل أُصيب ولدي عليّ؟ فقال لها: «لا يا ليلى، ولكن برز له مَن أخاف منه عليه، يا ليلى ادعِ لولدِكِ عليَ، فأنّي سمعتُ جدّي رسولَ الله’ يقول: دُعاء الوالدة مُستجاب بحقّ ولَدِها»، دخلت ليلى إلى خيمتها، رفعت يدَيها إلى السّماء قائلة: إلهي بغربة أبي عبد الله! إلهي بعطش أبي عبدالله! إلهي بوحدة أبي عبد الله! يا رادّ يُوسف إلى يعقوب، اردُد إليّ ولدي عليّ.
|
ردت الخيمتها الغريبة |
أريـدك عـليّ سـالـم تـجيـبـه
فاستجاب الله دُعاء ليلى لولدها ونصر علياً الأكبر على بكر بن غانم، فقتله واحتزّ رأسه وجاء إلى أبيه الحسين وهو يقول:
|
صيدُ الملوك أرانب وثعالب |
يا أبة هل من جائزةٍ؟ فقال له أبوه الحُسين: بُني عليّ وأيُّ جائزةٍ تُريدُ من أبيك؟ فقال: يا أبة، فهل إلى شربةٍ من ماء سبيل أتقّوى بِها على الأعداء؟ فقال له أبو عبد الله×: بُني عليّ اصبر قليلاً سيسقيك جدُّك المُصّطفى بكأسه الأوفى شُربةً لا تظمأ بعدها أبداً، فرجع عليُّ الأكبر يُقاتل حتى قتل تمام المائتين.
يقول أرباب المقاتل: رأينا عليّاً الأكبر، وهو يطرُد كتيبةً أمامه، فطعنه مُرّة ابن مُنقذ (لعنه الله) برُمحه فانقلب على قُربوس سرج فرسه واعتنق الفرس، فحمله إلى معسكر الأعداء فاحتوشوه، وقطّعوه بسيوفِهم إرباً إرباً، ولمّا بلغت روحُه التراقي نادى: أبه، عليك مِنّي السلامُ، هذا جدّي رسولُ الله قد سقاني بكأسه الأوفى، شربةً لا أظمأ بعدها أبداً، قالت سكينة: لمّا سمع أبي صوت عليّ أخذ تارةً يقوم وأُخرى يجلس وهو يقول: وا ولداه.
آه:
|
شبگ على المُهر لباله يُودّيه لبوه احسين عن الگوم يحميه |
وأمّا الحوراء زينب‘ فإنّها هوت على ذاك الجسد الطاهر تلثمه تقبيلاً:
|
هوت فوگه
تشم خدَّه وتحبه |
***
|
ونادت زينبُ الكُبرى بصوتٍ |
المحاضرة العشرون: إقامة الصلاة
|
هُم فتيةٌ خطبُوا العُلى بسيوفِهم |
***
وكأنّي بزينب‘ في ليلة عاشوراء تُحدّث الليلَ ودمعتُها تَهلُّ على خدّيها:
|
تحاچي اللّيل بت حيدر |
اوويــــــلاده وإخـــــوانــــــه
|
أدري بصحبك يروحون |
اولا واحــد الــيــحمـــانــــه
قال تعالى في مُحكم كتابه الكريم: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾[365].
في هذه الآية عِدّةُ بُحوثٍ نتعرّضُ لها على التوالي إن شاء الله تعالى.
البحثُ الأول: ما هو المعنى الإجمالي لهذه الآية؟
المعنى الإجمالي للآية هو الحثُّ على الصّلاة وبيان أوقاتِها وثمراتها.
البحث الثاني: ما هو مَعنى هذه الآية عِند أهل البيت^؟
والجواب: إنَّه رُوي عن حريز عن الإمام الصّادق× قال: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ﴾ وطرفاه المغرب والغداة ﴿ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ وهي صلاة العشاء الآخرة[366].
وتعتبر هذه الآية من الآيات الّتي تحتوي على رجاء في رحمةِ الله لايدانيه رجاء في سَواها من الآيات، فعن أبي حمزة الثُمالي قال: سمعتُ أحدَهما÷ يقول: «إنَّ علياً× أقبل على الناس فقال: أيُّ آيةٍ في كتاب الله أرجى عندكم؟» فقال بعضُهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾[367]. قال: «حسنة وليس إيّاها». فقال بعضهم: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا﴾[368]. قال: «حسنة، وليست إيّاها». وقال بعضهم: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ﴾[369] قال: «حسنة وليست إيّاها».
قال: ثُمّ أحجم الناسُ، فقال: «مالكم، يا مَعشَرَ المسلمين؟» قالوا: لا والله، ما عِندنا شيء، قال: «سمِعتُ رسول الله’ يقولُ: أرجى آية في كِتابِ الله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ وقرأ الآية كُلَّها، وقال: يا عليُّ، والذي بعثني بالحقِّ بشيراً ونذيراً، إنَّ أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط من جوارحه الذُنوب، فإذا استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء، كما ولدتَه أُمّه، فإذا أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مِثلُ ذلك، حتّى عدَّ الصلوات الخمس، ثُمَ قال: يا عليّ، إنّما منزلةُ الصّلوات الخمس لأُمّتي كنهرٍ جارٍ على بابِ أحدكم، فما ظنُّ أحدِكم لو كان في جسده دَرَن؟ فكذلك والله الصلوات الخَمس لاُمّتي»[370]؛ ولذلك ورد في الحديث الشريف «الصّلاة صابون الخطايا»[371].
البحث الثالث: محلّ هذهِ الآية جاء بعد عدّة أوامر ونواهي، مِنها: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ﴾[372] إلى غيرها من الآيات، عندما أمر الله تبارك وتعالى نبيّه’ بالاستقامة أردفه بالأمر بالصّلاة، وذلك يدلُّ على أنّ أعظم العبادات بعد الإيمان بالله هو الصّلاة، واعتبر الخوارج أن هذه الآية مُستمسكاً، فتمسّكوا به في أنَّ الواجب من الصّلاة ليس إلّا الفجر والعشاء، مستدلّين بوجهين:
الوجه الأوّل: أنّ الفجر والعشاء واقعان على طرفي النهار، وأمّا عبارة ﴿وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ فهي صفة لطرفي النهار.
والوجه الثاني: أنَّ الآية ذكرت: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ وعبّرت عن الصّلاة بأنّها حسنات، وهذا يتحقّق في الصّلاتين.
وهذا الرأي باطل بإجماع الأُمّة الإسلاميّة فلا يُلتفت إليه[373].
البحث الرابع: ما معنى طرفي النهار؟ معناه أقمّ الصّلاة في الصّباح والمساء وفي ساعاتٍ من الليل هي أقرب من النهار، وينطبق من الصّلوات الخمس اليومية على صلاة الصُّبح والعصر، وهي صلاة المساء والمغرب والعشاء الآخرة.
البحث الخامس: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ تعليل لقولهِ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ وبيان أنّ الصلوات حسنات واردة على نفوسِ المؤمنين، تذهبُ بآثار المعاصي وهي ما تعتريها مِن السيئات. ومن بعد ذلك قال تعالى: ﴿ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ أي: هذا الذي ذُكر وهو ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ـ على رفعةِ قَدره ـ تذكار للمتلبسين بِذكرِ الله تعالى من عباده[374].
ولذلك يُعبِّر أميرُ المؤمنين× عن الصّلاة «أنَّها قربان كلِّ تقيٍّ»[375]، إضافةً إلى أنّ الصّلاة تُنزّل الإنسان عن مواطن الكِبر، والتنزّه عن الكِبر من مُقوّمات شخصية المُسلم، فلم تُفرَض الصّلاة لِذاتها وإنّما لتكون الوسيلة التي يتذلل بها الإنسان لخالقه، والمُحفّز للإنسان على الشُعور بسائر مسؤولياته، قال تعالى: ﴿ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ﴾[376]، والدعامة الّتي يُستند إليها عند وُقوع المُهمّات، وحُلول الكوارث والخُطوب والزلازل وبقيّة المضايقات النفسيّة وغيرها؛ ولذلك نجد أنَّ النبيّ الأكرم’ بَذَلَ كُلَّ ما بوسعهِ من أجل اغتنام هذه الفريضة العظيمة، وما نرى فريضة لها تلك الأهميّة، كالصّلاة، واجبها ومستحبها، حتّى أصبحت الفارق الحقيقي بين المُسلم والكافر، والفارق بين الإنسان المجنون والعاقل، قال الأصمعي: رأيتُ سعدون المجنون جالِساً عِند رأس شيخٍ [أي رجل كبير السن]سكران، يذبُّ عنه الذُباب، فقُلتُ له: أنت مجنون أم هو؟ قال: بل هو، قُلتُ: مِن أين؟ قال: لأنّي صليتُ الظّهر والعصر في جماعةٍ، وهو لم يُصلّ جماعةً ولا فُرادى، فقال شعراً، فقُلتُ له: صدقت وانصرفت»[377] إذن الصّلاة لها الأهميّة الكبرى في تقويم حياة الإنسان، ونرى في التأريخ أصحاب الرسول الأكرم’ وأصحابَ أمير المؤمنين× قد اهتمّوا بهذه الفريضة، وحافظوا عليها؛ لأهميتها في التأثير على سُلوك الفرد والمجتمع، فهي هوّية المؤمن التي إن قُبلت قُبل ما سواها وإن رُدت رُدَّ ما سواها كما في الرواية[378].
في يوم من الأيام دخل عقيل بن أبي طالب على مُعاوية، فلمّا دخل واستقرّ به الجُلوس في المجلس سأل مُعاوية عقيلاً قائلاً: أنت دخلت في معسكرين، معسكر أخيك عليّ ومُعسكري، فما الفرق بين المعسكرين، هل تستطيع أن تبيّنه؟
قال عقيل: دخلتُ على مُعسكر أخي فرأيتُ لَيلهم كليلِ رسول الله، ونَهارهم كنهار رسولِ الله، بين قائمٍ وقاعدٍ وراكعٍ وساجدٍ وصائم، إلّا أنَّ رسولَ الله’ ليس فيهم، ودخلتُ إلى مُعسكرك فما وجدت فيهم إلّا قوماً ممَّن نفّر ناقة رسولِ الله’ ليلةَ العقبة[379].
ولأهميّة الصّلاة نجد أنَّ أصحاب الحُسين مع إمامِهم وأهل بيته^ قد انشغلوا في ليلةِ عاشوراء بالصّلاة، حتّى صار لهم دويٌّ كدويّ النّحل، مِن الصّلاة وقراءة القرآن والأدعية.
رُوي عن الإمام زينِ العابدين× أنّه قال: «لمّا كان الليلة العاشرة من المُحرّم قام أبي الحسينُ× في أصحابه خطيباً، فقال: يا أصحابي، إنّ هؤلاء يُريدونني دونكم، ولو قتلوني لم يصلوا إليكم، فالنجاة النجاة وأنتم في حلٍّ مِنّي، فإنّكم إن أصبحتم معي قُتلتم كُلّكُم. فقالوا: لا نخذلك ولا نختار العيش بعدك، فقال×: إنّكم تُقتلون حتّى لا يفلت مِنكُم أحدٌ. فقالوا: الحمدُ لله الّذي شرَّفنا بالقتلِ معك. ثمّ إنّه دعا لهم، وقال: إرفعوا رُؤوسكم وانظروا. فجعلوا ينظرون إلى منازِلهم في الجنّة»[380].
ويُروى أنّه قال في آخر خُطبته: «أصحابي وعمومتي أهل بيتي، ألا ومَن كانت في رحله امرأة فليبعث بها إلى أهلها، فإنّ نسائي تُسبى وأخافُ على نسائكم السّبي. فقام من بينهم حبيب بن مُظاهر الأسدي، وأقبل إلى خيمته فتبسّمت زوجته في وجهه، فقال لها: دعينا والتبسّم، قُومي والحقي ببني عمِّك مِن بني أسد. فقالت: لِمَ يابن مُظاهر؟ هل فعلتُ معَك مكروهاً؟ قال: حاشا لله، ولكن أما سمعتِ غريبَ رسولِ الله’ خطبنا في هذهِ السّاعة؟ قالت: بلى، ولكن سمعتُ في آخر خُطبتهِ همهمةً لا أعرفُها؟ قال: خطبنا وقال: ألا ومَن كانت في رحله امرأة فليبعث بها إلى أهلها، فلمّا سمعت الحُرّة نطحت رأسها بعمود الخيمة، وقالت: ما أنصفْتَني يا بن مُظاهر أيسرّك أن تُسلبَ زينب إزارها وأنا أتزيّنُ بإزاري؟! أم يسرَّك أن سُكينة يُسلبُ قِرطُها وأنا أتزيّنُ بقُرطي؟! لا كان ذلك أبداً، بل أنتُم تواسون الرّجال ونحنُ نواسي النساء، فلمّا سَمِعَ مِنها ذلك رجع إلى الحُسين× فرآه جالساً ومعه أخوه العبّاس، فسلم عليهما وجلس، وقال: أبت الأسديّةُ أن تُفارقَكُم. فقال الحُسين×: جزاكم الله خير الجزاء»[381].
وبالفعل ـ في يوم العاشر من المُحّرم ـ هؤلاء الأبطال قدّموا كُلَّ ما عندهم من أموال وأرواح في سبيل أبي عبد الله الحُسين×؛ لأنّه حُجّةُ الله وخليفته في أرضه، وكذلك سيّدهم وقائدهم الإمام الحُسين× قدّم حتّى الطّفل الرضيع. يذكر أرباب المقاتل أنّه عندما جاءت الحوراء زينب‘ إلى أخيها الحُسين×، وكانت تحمل معها عبد الله الرضيع×، فدفعته إليه وهي باكية، قالت: أخي خُذ طِفلك فأخذه ووضعه في حِجره يُقبّله، ويقول: «بُعداً لهؤلاء القُوم إذا كان جدُك المصطفى خصمهم»، ثُمَّ أتى به نحو القوم يطلب له الماء قائلاً: «يا قوم، قد قتلتم إخوتي وأولادي وأنصاري وما بقي غير هذا الطِفل، وهو يتلظّى عطشاً من غير ذنبٍ أتاه إليكم، فاسقوه شربةً من الماء». فاختلف المعسكر فيما بينهم، مِنهم مَن قال: إذا كان ذنبٌ للكِبار فما ذنبُ هذا الطفل؟ ومنهم مَن قال: اقتلوه، ولا تبقوا لأهلِ هذا البيت باقية. فلمّا رأى ابنُ سعد ذلك صاح بحرملة: ويلك يا حرملة، اقطع نزاع القوم. قال: فما أصنع؟ قال: ارمِ الطفل بسهمٍ. قال حرملة: فرأيتُ رقبتَه تلمع على عضُدِ أبيه الحُسين× فرميتُ الطفل بسهمي، فذبحته من الوريد إلى الوريد، فلمّا أحسّ الطفل الرضيع بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق أباه، وجعل يُرفرف كالطير المذبوح، فملأ الحُسينُ كفّه من دمه، ورمى به نحو السّماء، قائلاً: «اللهمَّ لا يكن أهون عليك من فصيلِ ناقة صالح»[382].
وكأنّي به واقف وهو يحمل الطفل الرضيع بين يديه:
(نصّاري)
|
تلگه حسين دم الطفل
بيده شحال اليچتل
بحضنه وليده |
***
توجهت سكينه إلى أخيها الطفل الرضيع وكأنّي بها تناديه:
|
يخويه عون من حبَّك وشمّك |
فلو أنَّ موتاً يُشترى لاشتريتُه
وعيشـيَ بعد الظامنين مُنكّدُ
المحاضرة الحادية والعشرون: علاج ترك الذنوب والمعاصي
|
الله أيُّ دمٍ في كربلا سُفكا |
***
|
يا فاطمة يم البدور ومن العطش چبد حسين مفطور هذا الجره في يوم عاشور |
ولسان حال الحوارء زينب‘:
|
يا فاطمة يمّ الميامين |
||
|
|
وأنــا ادخــلـت يــمّــه الـدواويــن |
|
***
رُوي أنَّه جاء رَجلٌ للإمام الحُسينِ× وقال له: أنا رجلٌ عاصٍ ولا أصبرُ عن المعصية، فعظني بموعظةٍ، فقالَ×: «افعل خمسةَ أشياءٍ واذنب ما شئت، فأوّل ذلك: لا تأكل من رزقِ الله واذنب ما شئت، والثاني: اخرجْ مِن ولايةِ الله واذنب ما شئت، والثالث: اطلب موضعاً لا يراك الله واذنب ما شئت، والرابع: إذا جاء مَلَكُ الموت ليقبض روحَك فادفعه عن نفِسك واذنب ما شئت، والخامس: إذا أدخَلَك مالكٌ في النّار فلا تدخل في النّارِ واذنب ما شئت»[384].
من أهمّ الطُّرق لعلاجِ المشاكل الأخلاقية هي عدم المباشرة بالعلاج، بل الابتداء بمقدّمات علاجية توصل المكلّف نفسَه للتفكّر، وبعدها إلى حسم المشكلة، وهذا هو ديدن أهل البيت^ في علاجاتهم لمُجمل المشاكل. ولعلّ هذا الأُسلوب داخل في قوله تعالى: ﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ﴾[385] فمن الحكمة أن نتكلّم بالأُسلوب غير المباشر مع النّاس كما كان يصنع الإمام الصّادق وباقي الأئمّة^ مع بعض العُصاة، كما في قصّة الشّقراني، وصفوان الجمّال، حيث عبّر سلام الله عليه بالإشارة إذ قال للشّقراني: «الحسنُ من كُلِّ أحدٍ حسنٌ ومِنكَ أحسن؛ لقربكَ منّا، والقبيح من كُلِّ أحدٍ قبيح ومنك أقبح؛ لقربك منّا»؛ إذ أنَّ الشّقراني كان مُقيماً على شرب الشّراب المحرّم[386]، وبهذه الكلمة استطاع الإمام× أن يُغيّرَ حياة الشّقراني. وهكذا ديدن الأئمّة^ تبعاً لجدّهم المُصطفى مُحمَّدٍ’ بلا فرقٍ في كون الموعظة لأجل ترك المعصية، أو لأجل الاهتمام بالعبادة والطاعة والمواظبة عليهما، ومن هنا نعرف وصايا النبيّ للإمام أمير المؤمنين× ووصايا الإمام× لأولادِه بأنَّها كانت أكثرها تحت عنوان «إيّاك أعني واسمعي يا جارة»[387].
وبنفس هذا الأُسلوب وعظ الإمام الحسين× هذا الرجل المبتلى بالمعصية، بأنَّ الإمام لم يقل له لا تعصِ، وإنّما قال: «افعل ما شئت»، وهذا معناه اعصِ لكن بشروطٍ خمسة، إذا أنت حقّقتها فاعصِ بما تحب وترغب.
أولها: «لا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت»، أي: يحقُّ لك أن تذنب وتعصي لكن بشرط ألّا تأكل من رزق الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو الّذي يُطعم ويسقي قال: ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾[388] كما جاء على لسان نبيّ الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام حين كان يخاطب قومَه العصاة الفجرة: بأنّكم تعصون الله، بل وتعبدون سواه، وهو الّذي يطعم ويسقي، ويمرض ويشفي، ويُميت ويُحيي.
ففي نفس الوقت الّذي يأمر الله تبارك وتعالى عباده بأكل رزقه ويبيحه لهم، في نفس الوقت ذاته ينهاههم عن العبث والفساد في الأرض، حيثُ يقول: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾[389].
يبيح لعباده التمتّع بملذّات الدُّنيا بشرط عدم الفساد والإفساد في الأرض، ورزق الله هو كلّ ما كان منه بالمباشرة أو بالأسباب؛ لأنّه لا مؤثّر في الوجود إلّا الله تبارك وتعالى.
فإذا كان الإنسان عنده أولاد يعملون فيطعمونه، فهو يأكل من رزق الله، أو كان يعمل فيطعم نفسه، فهو من رزق الله.
فالأكل من رزق المضيّف يحرّم على الضيف التمرّد عليه كما هو ديدن العُرف، فإنّ الإنسان إذا دخل في دار أحد وأكلَ منها امتنع عن سرقته وغيبته والنظر المحرّم إلى أهلِ داره؛ لأنّه أَكَلَ من رزقه، فكيف بمَن هو الرزّاق المطلق، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾[390].
والخلاصة فالإمام الحسين× يقول لهذا الرجل: اعصِ لكن لا تأكل من رزق الله، وبما أنَّه من المستحيل ألّا يأكل من رزق الله، لأنَّ كلَّ الطعام له}؛ كان عليه أن يمتنع عن المعصية.
ثانيها: «اُخرج من ولاية الله واذنب ما شئت!» كيف يخرج من ولايته وهو القائل: ﴿ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾[391]، وقال تعالى: ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴾[392]، وقال تعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾[393]، وقال: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾[394]، وغيرها من الآيات الدالّة على أنّ الولاية ـ أولاً وبالذات ـ له}، لا يمكن لأحدٍ أن يخرج عن ولايته سبحانه وتعالى، كيف يصير الإنسان مستقلّاً بشؤونه وهو الفقير المطلق؟!
وثالثها: «اطلب موضعاً لا يراك الله واذنب ما شئت!»
أي: إذا أردتَ أن تعصيَ الله تعالى فعليك أن تتذكّر أوّلاً أنّه لا يخفى عليه شيء ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾[395] وهو الّذي يعلم ما في أنفسنا حيث يقول: ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾[396]، وهو العالم بكلّ شيء حيث يقول: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾[397]، وقال: ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾[398].
وهذا بديهي جدّاً، وما أكثر ما نطق به القرآن الكريم من آيات تتعلّق بعلمه} بدقائق الأُمور وأسرارها، حتّى صار الأمر ضرورة يعرفها الصغار فضلاً عن الكبار.
يُذكر أنَّ معلّماً قال لصبيان كان يعلّمهم القرآن: مَن منكم يأخذ هذا العصفور إلى مكانٍ بحيث لا يراه أحدٌ؟ فقال أحد الصّبيان الأذكياء: كيف نستطيع أن نأخذَ هذا العصفور إلى مكانٍ لا يرانا أحدٌ فيه والله تبارك وتعالى محيط بنا من كلّ جانب وموجود في كلّ مكان، فقال المعلّم للصّبي: أحسنتَ، إنَّ الله تبارك وتعالى معنا، وأنا أردت أن تعلموا هذا المعنى وحقيقته.
ويُروى أنَّ زُليخا لمّا همّت بالمعصية مع نبيِّ الله يوسف× قامت إلى صنمٍ في بيتها فألقت عليه مُلاءة[399] لها، فقال لها يوسف: ما تعملين؟ فقالت: ألقي على هذا الصنم ثوباً لا يرانا فإنّي أستحي منه، فقال يوسف: أنت تستحين من صنمٍ لا يسمع ولا يُبصر ولا أستحي من ربّي؟ فوثب وعدا وعدت من خلفه وأدركهم العزيز على هذه الحالة وهو قول الله: ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾[400].
ورابعها: «إذا جاءك ملَك الموت، ليقبض روحك، فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت».
ورابع هذه الشروط أن ادفع عن نفسك ملَك الموت إذا جاء لقبض روحك، فإن استطعت دفعه فاذنب ما شئت.
كيف يستطيع الإنسان أن يدفع عنه هذا الملك أو الملائكة العظام الشّداد الّذين وصفهم خالقهم بأنّهم: ﴿مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾[401].
وهو الّذي يصف سكرة الموت بقوله عزّ مَن قائل: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾[402].
وقال: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾[403].
ويكفيك معرفة بعظمته وقوّته وتوفيه للنفس ما وصفه به الإمام أمير المؤمنين الإمامُ عليّ× حيث يقول: «هل تحسُّ به إذا دخلَ منزلاً؟ أم هل تراه إذا توفّى أحداً؟ بل كيفَ يتوفّى الجنينَ في بطنِ أُمّه، أيلج عليه من بعض جوارحها؟ أم الروح أجابته بإذن ربّها؟ أم هو ساكنٌ معه في أحشائِها؟ كيف يصف إلهَه مَن يعجز عن صفةِ مخلوقٍ مثله»[404].
فملك الموت الّذي لا يحسّ به أحدٌ هو الموكّل بقبض روح هذا المخلوق الضعيف، ويلج إليه من حيث لا يشعر.
وقد قرّب أميرُ المؤمنين× هذا المعنى لبعض مَن سأله عمَّن يسدّ بابه من أين يأتيه رزقُه؟ فقال× «من حيث يأتيه أجلُه»[405].
فإذن ملك الموت هذا لا نحسُّ به إذا جاءنا، ولا نستطيع دفعه، ومتى ما شعرنا بحضوره واستطعنا دفعه عن أنفسنا حينئذٍ نحن في غاية القوّة والجبروت، فلا نحتاج إلى ربّ نعبده وإلهٍ نطيعُه!!
فالإمام الحُسين× ينصح هذا الرّجل المبتلى بالمعصية بهذا البيان الرائع، والمستحيل أن يتحقّق للمخلوقين من عباده الضعفاء وهو: «متى ما استطعت أن تدفع ملَكَ الموت عنك فادفعه واذنب ما شئت» وبما أنَّ التالي لا يمكن تحقيقه فعليك أيها العبد المبتلى ألّا تعصي الله؛ لأنَّك لم تستطع دفع الضيم عن نفسك فاتّقِ الله واستعن به.
وخامسها: «إذا أدخلَك مالكٌ في النّار، فلا تدخل في النار واذنب ما شئت!»
وخامس الشروط وأخيرها الّتي ذكرها الإمام الحُسين× لهذا العبد المُبتلى بالمعصية هو ما بعد الوفاة، بمعنى أنَّك أيُّها العبدُ المُبتلى بالمعصيَة إذا متّ وأنتَ على هذا الحال فإنَّ مصيرَك إلى النار، ولكن هل فكّرت بأنَّك لا تستطيع أن تدفَع عن نفسِكَ في ذلك اليوم السَّوق الّذي يسوقك به مالك خازن النيران إلى النَّار؟ فإن كُنتَ تستطيع منازعَتَه وعدم الانصياع له فاذنب ما شئت.
وخازن النيران مَلَك لا يسمع شكوى للعاصين، ولا رجاءً من المذنبين، قال تعالى ـ واصفاً حال أهل النار معه ـ: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ ﴾[406]، وفي حديث المعراج أنَّ رسول الله’ مرّ على ملكٍ قاعد على كُرسيّ فسلّم عليه، فلم يرَ منه من البِشر ما رأى من الملائكة، فقال: يا جبرئيل، ما مررت بأحد من الملائكة إلّا رأيتُ منه ما أحبّ إلّا هذا، فمَن هذا الملك؟ قال: هذا مالكٌ خازن النّار، أما أنّه قد كان من أحسن الملائكة بِشراً، وأطلقهم وجهاً، فلمّا جُعل خازن النار اطّلع فيها اطّلاعة، فرأى ما أعدّ الله فيها لأهلها، فلم يضحك بعد ذلك[407].
وقد رُويَ أنّه لمّا وُلد الإمام الحسين× أوحى الله} إلى مالك خازن النار: أن أخمد النيران على أهلها لكرامة مولود ولد لمحمّد’[408].
فالله تبارك وتعالى أخمد النيران كرامة للإمام الحسين× ولكنَّ القومَ أضرموا النيران وأحرقوا الخيام، بُغضاً وعداوة لأبي عبد الله× وأهل بيته الكرام في يوم العاشر من المحرّم.
ومن هنا رُويَ: أنّه لما هجم القوم على المخيّم ارتفع صياح النساء، فصاح ابن سعد: اكبسوا عليهنّ الخباء واضرموها ناراً فأحرِقوها ومَن فيها.
فقال له رجل منهم: ويلك يا بنَ سعدٍ، أما كفاك قتل الحسين وأهل بيته وأنصاره عن إحراق أطفاله ونسائه؟ فقد أردت أن يخسف الله بنا الأرض؟
فامتنع ابن سعد، ولكنّه نادى عليّ بمشعل من نارٍ لأحرق بيوت الظالمين، فجاؤوا إليه بمشعل، فأضرم النار في المُخيّم، ففرَّ عيال وبنات رسول الله والتجؤوا إلى السيدة زينب‘[409].
وكأنّي بهنّ:
(مجاريد)
|
فرن اوكل وحده ابمشيها وأطفالها تبچي البچيها |
ولذا بقيت الحوراء زينب‘ في حيرة من أمرها ودهشة، من قساوة عدوها.
(فائزي)
زينب احتارت يوم شبّوا بالخيم نار
طلعت ويّاها الحريم اصغار واكبار
تصـرخ بعالي الصوت طايح وين يحسين
خدري انهتك وأنت غياث المستغيثين
عجّل ادركنه اتهتّكت خويه النساوين
لمن سمع گام ايتگلب والدمه فار
وكأنّي به× يجيبها:
گلها يزينب باليتامة لا تجيني
اولا تكثرين امن البواچي اتهيجيني
ردي اسكينه لا يذوّبها ونيني
لا تكثري عتبي ولا اتجيني بلا اخمار
لا تكثري عتبي وأنا جثة بِلا راس
راسي اگبالچ والجسد بالخيل ينداس
گصدي الشـريعة بلكن اتشوفين عبّاس
يگدر على الگومه اويسل سيفه البتّار
وكأنّي بها‘ تنادي كافلها أبا الفضل العبّاس×:
|
يعبّاس دير العين لينه |
***
|
عبّاس تسمعُ زينباً تدعوك مَن |
المحاضرة الثانية والعشرون: معطيات آية المباهلة
|
يابنَ النبيِّ المُصطفى ووصيّهِ |
***
وكأنّي بالحوراء زينب‘ لمّا نظرت إلى أخيها أبي عبد الله× ويزيد يقرع بعصاه ثناياه:
|
يحسين راسك حين شفته |
قولُه تعالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾[411].
«أجمع أهل القبلة ـ حتّى الخوارج مِنهم ـ على أنَّ النبيَّ’ لم يدعُ للمباهلة من النساء سوى بضعته الزّهراء، ومن الأبناء سوى سبطيه وريحانتيه من الدُنيا، ومن الأنفس إلّا أخاه الّذي كان منه بمنزلةِ هارون من مُوسى، فهؤلاء أصحاب هذه الآية بحُكم الضرورة التي لا يُمكن جحودها، لم يُشاركهم فيها أحدٌ من العالمين كما هو بديهيٌّ لكُلِّ من ألمَّ بتاريخ المسلمين، وبهم خاصّة نزلت لا بسواهم.
وأوردها ابنُ حجر في الباب الحادي عشر من صواعقه أنّ عليّاً يوم الشّورى احتجَّ على أهلها فقال لَهُم: أُنشدكم بالله هل فيكم أحد جعله الله نفس النبيّ، وأبناءه أبناءَه، ونساءه نساءه غيري؟ قالوا: اللهمَ لا...» الحديث[412].
فباهلَ النبيَّ’ بهم خصومه من أهل نجران فبهلهم، وأُمّهات المؤمنين كُنَّ حينئذٍ في حجراته’، فلم يدعُ واحدة منهُنَّ وهُنّ بمرأى منه ومسمع، ولم يدعُ صفيّة وهي شقيقة أبيه وبقيّة أهليه، ولا أُمّ هاني ذات الشأن والمكان، وهي كريمة عمّهِ الفارج لهمّه، ذي الأيادي الّتي هي من المُسلمين طوق الهوادي، ولا دعا غيرَها من عقائل الشّرف والمجد، ولا واحدة من نساء الخُلفاء الثّلاثة وغيرهم من المهاجرين والأنصار، كما أنّه لم يدعُ مع سيديَّ شباب أهل الجنّة أحداً من أبناء الهاشميين، على أنّهم كانوا (إذا رأيتهم حسبتَهم لؤلؤاً منثوراً)[413] ولا دعا أحداً من أبناء الصّحابة على كثرتهم ووفور فضلهم.
وكذلك لم يدعُ من الأنفس مع عليٍّ عمَّه وصنو أبيه العبّاس بن عبد المطّلب، وهو شيخ الهاشميين، وأجود القرشيين وأعظمُ النّاس عند رسول الله’، بل لم يدعُ أحداً من كافّة عشيرته الأقربين، ولا واحداً من السابقين الأوّلين (رضي الله تعالى عنهم أجمعين) وكانوا بمرأى من المباهلة وسمعٍ من المنتدى والمجمع فلم ينتدب واحداً منهم مع مَن انتدبهم إليها، بل لم ينتدب أحداً من سائر أهل الأرض بالطّول والعرض، وإنّما خرج’ ـ كما نصَّ عليه الرازي في تفسيره ـ وعليه مرط من شعرٍ أسود وقد احتضنَ الحُسين، وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعليٌّ خلفها وهو يقول: «إذا أنا دعوتُ فأمّنوا»، فقال أسقف نجران: يا معشر النصّارى، إنّي لأرى وجُوهاً لو سألوا الله أن يُزيلَ جبلاً لأزاله بها، فلا تباهلوهم فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة[414].
وهنا فوائد لا بُدّ من التعرّض إليها:
الأُولى: قد ذكر الزمخشري في تفسيره: «أنَّ الباري قدّمهم في الذّكر على الأنفس ليُنبّه على لُطف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن بأنّهم مُقدّمون على الأنفس مفدون بها. وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء^، وفيه بُرهان واضح على صحّة نبوّةِ نبيّ الإسلام’؛ لأنّه لم يَروِ أحدٌ من موافقِ ولا مُخالفٍ أنّهم أجابوا إلى ذلك»[415].
الثانية: وذكر الفخر الرّازي في تفسيره: «أنّه كان في الرّي رجلٌ يُقالُ له: محمود بن الحسن الحَمْصي، وكان مُعلّم الاثني عشريّة، وكان يزعم أنَّ علياً أفضل من جميع الأنبياء سوى مُحمّدٍ’ قال: والّذي يدلّ عليه قولُه تعالى: ﴿وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ﴾ وليس المراد بقوله ﴿وَأَنْفُسَنَا ﴾ نفس مُحمّدٍ ’؛ لأنّ الإنسان لا يدعو نفسَه، بل المراد غيره، وأجمعوا على أنّ ذلك الغير كان عليَّ بنَ أبي طالبٍ ، فدلّت الآية على أنّ نفس عليٍّ هي نفس مُحمّدٍ، ولا يمكن أن يكون المراد منه أنَّ هذه النفس هي عين تلك النفس، فالمراد أنَّ هذه النفس مثل تلك النفس، وذلك يقتضي الاستواء في جميع الوجوه تركَ العمل بهذا العموم في حقِّ النبّوّة وفي حقِّ الفضل؛ لقيام الدلائل على أنَّ مُحّمداً’ كان نبيّاً وما كان عليّ كذلك، ولانعقاد الإجماع على أنّ مُحمّداً’ كان أفضلَ من عليٍّ ، فيبقى ما بعده معمولاً به، ثُمَّ الإجماع دلّ على أنّ مُحمّداً’ كان أفضل من سائر الأنبياء^، فيلزم أن يكونَ عليٌّ أفضلَ من سائر الأنبياء، فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية.
ثُمَّ قال: ويؤّيد الاستدلال بهذه الآية، الحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو قولُه’: مَن أراد أن يَرى آدمَ في علمهِ ونُوحاً في طاعتهِ وإبراهيمَ في خِلّته ومُوسى في هيبتهِ وعِيسى في صَفوتهِ فلينظرْ إلى عليِّ بن أبي طالب[416]، فالحديث دلّ على أنّه اجتمع فيه ما كان متفرّقاً فيهم، وذلك يدلُّ على أنّ عليّاً أفضل من جميع الأنبياء سوى محمّدٍ’.
وأمّا سائر الشّيعة فقد كانوا ـ قديماً وحديثاً ـ يستدلّون بهذه الآية على أنَّ عليّاً أفضل من سائر الصّحابة؛ لأنَّ الآية لمّا دلّت على أنّ نفسَ عليٍّ مثل نفس مُحمّدٍ’ إلّا فيما خصّه الدليل، وكان نفس مُحمّدٍ أفضل من الصّحابة (رضوان الله عليهم) فوجب أن يكون نفس عليّ أفضل أيضاً من سائر الصحابة»[417].
ثُمَّ إنَّه ذكر كلاماً في غاية العناد والمكابرة لردِّ هذا الاستدلال السليم.
الثالثة: وهي نكتة مهمّة لا يعرف كنهها إلّا عُلماء البلاغة ولا يقدّرُ قدَرها إلّا الراسخون في العلم العارفون بأسرار القُرآن ألا وهي: إنَّ الآية الكريمة ظاهرة في عموم الأبناء والنساء والأنفس، كما يشهد به عُلماء البيان، ولا يجهله أحدٌ ممَّن عرف أنَّ الجمع المضاف حقيقة في الاستغراق، وإنّما أطلقت هذه العمومات عليهم بالخصوص تبياناً؛ لكونهم مُمثّلي الإسلام، وإعلاناً بكونِهم أكمل الأنام، وصفوة العالم، وبرهاناً على أنّهم خيرة الخيرة من بني آدم، وتنبيهاً إلى أنّ فيهم من الرّوحانية الإسلاميّة والإخلاص لله في العبودية، ما ليس في جميع البريَّة، وأنَّ دعوتَهم إلى المُباهلة بحُكم دعوة الجميع، وحصرهم خاصّة فيها مُنزّلٌ منزلةَ حُضور الأُمّة، وتأمينهم على دُعائه مقدّمٌ عن تأمين مَن عداهم، وبهذا جاز التجوّز بإطلاق تلك العمومات عليهم بالخصوص، ومَن غاص في أسرار الكتاب الحكيم وتدبّره ووقف على أغراضه يعلم أنّ إطلاق هذهِ العُمومات عليهم بالخصوص إنّما هو على حدّ قول القائل:
|
ليس على الله بمُستنكر |
ولذا ـ كما ذكرت آنفاً ـ قال الزّمخشري في تفسيره: وفيهِ دليل لا شيءَ أقوى منه على فضل أصحاب الكساء^.
الرابعة: إنَّ هذهِ الآية الّتي دلّت على أنَّ أمير المؤمنين× هو نفسُ النبيِّ’ لو ضممتها إلى آية أُخرى، وتأخذ من تلك كلمة ﴿وَأَنْفُسَنَا ﴾ ومن هذهِ أيضاً في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾[419] وأمعنت النظر في الآيتين يتجلّى لك من الأسرار ما كان خفيّاً[420].
الخامسة: ومن طريق المُخالفين: ما رواه مُوفّق بن أحمد ـ وهو من كبار علمائِهم ـ قال: أخبرنا قُتيبة، قال: حدّثنا فلان عن سعد بن أبي وقّاص قال: أمر مُعاوية بن أبي سُفيان سعداً فقال: ما منعك أن تَسُبَّ أبا تُراب؟ قال: أما ما ذكرتُ ثلاثاً قالهُنّ رسولُ الله’ لأن تكون لي واحدة أحبُّ إليّ من حُمرِ النعم، سمعتُ رسولَ الله’ يقول لعليّ× وخلّفه في بعض مغازيه: «تكون أنت في بيتي إلى أن أعودَ» فقال له عليّ×: «يا رسولَ الله، تُخلّفني مع النساء والصّبيان؟» فقال رسولُ الله’: «أما ترضى أن تكون مِنّي بمنزلةِ هارون من موسى إلّا أنّه لا نبوّةَ بعدي».
وسمعتُه يقول يومَ خيبر: «لأعطينّ الراية رجُلاً يُحبُّ الله ورسولَه ويُحبُّه الله ورسولُه» قال: فتطاولنا لها، فقال: «ادعوا لي عَليّاً»، قال: فأتى عليّ وبهِ رمدٌ، فبصقَ في عينيه ودفع الرّاية إليه، ففتح الله عليه، وأُنزلت هذه الآية: ﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ﴾[421].
ومعنى الآية: يا مُحمّد، فَمَن حاجّكَ من النصّارى في عيسى× من بعد ما جاءك من العلم، أيّ البيّنات الموجبة للعلم فباهلهم وقل لهم هذا القول حتّى يتبيّنَ الحقُّ من الباطل[422].
وأمّا قوله ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ ﴾ ففي تفسير القُمّي عن الصّادق×: «فقال رسولُ الله’: فباهلوني، فإنْ كُنتُ صادقاً أُنزلت اللعنةُ عليكم، وإن كنتُ كاذباً أُنزلتْ عليَّ، فقالوا: أنصفت، فتواعدوا للمباهلة، فلمّا رجعوا إلى منازلِهم قال رؤساؤهم، السّيد والعاقب والأهتم: إن باهَلَنا بقومهِ باهلناه، فإنّه ليس بنبيّ وإن باهلنا بأهل بيتهِ خاصّة فلا نباهلُه؛ فإنّه لا يُقدّمُ أهلَ بيتهِ إلّا وهو صادق، فلمّا أصبحوا جاؤوا إلى رسولِ الله’ ومعه أميرُ المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين^»[423].
ثُمَّ إنّهم قالوا: إنّا لنرى وجُوها لو دُعي بها على الجبال لانهدّت، تلك الوجوه هي وجوه آلِ مُحمّدٍ^، أيّ وجوهٍ تلك الّتي كانت مرآة عاكسة لنور الله: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾[424].
يا لها من ليلةٍ مؤلمةٍ مرّت على بنات رسولِ الله’ بعد ذلك العزّ الشامخ الّذي لم يُفارقهنّ منذُ أوجد الله كيانهُنّ، فلقد كُنّ بالأمسِ في سُرادق العظمة وأخبية الجلالة، وبقين في هذهِ الليلة في حلك دامس بعد فقد تلك الأنوار السّاطعة بين رحلٍ مُنتهبٍ، وخباءٍ محترق، وحُماة صرعى، لا مُحامي لَهُنّ ولا كفيل، ولا يدرين مَن يُدافع عنهُنّ إذا دهَمهنَّ داهم، ومَن يُسكنْ فورة الفاقدات ويخفض من وجدهنّ.
في هذه الليلة قامت الحوراء زينب‘ بجمع العيال والأطفال في مكانٍ واحدٍ، فلمّا جمعتهم أخذ الأطفال ينظرُ بعضُهم إلى البعض الآخر ودموعهم تتحادر على الخدود، وأخذوا يسألون الحوراء زينب، هذهِ تنادي: عمّه زينب أينَ أبي؟ وذاك يُنادي أين عمّي؟ وآخر يُنادي: عمّه، أينَ أخي؟ ماذا تجيبهم الحوراء زينب؟! أتقول لهم: أنّهم صرعى على الأرض؟ أم عندها جواب آخر؟ نعم قامت إليهم، أخذت تضمُ الطفلةَ إلى صدرها لتهدِئها عن البكاء والعويل، فإذا هدأت أخذت الأُخرى فضمّتها إلى صدرها، وكأنّي بها في تلك اللحظات، لحظات اللوعة والألم، تلتفت إلى أبي عبد الله الحُسين× تناديه ولكنّها لم تسمع منه جواباً، وأنّى له بالجواب، وقد فُرّق بين رأسه وجسده؟ لهذا حوّلت بوجهها إلى الغرّي شاكيةً مُصابَها لأبيها أمير المؤمنين×:
(مجاريد)
|
يبويه عليّه اللّيل هوّد |
(مجاريد)
|
يبويه علينه چلچل
اللّيل اودارت علينه الزلم والخيل |
(فايزي)
أمسه المسه والنار ماخلت لنا اخيام
صيوان ما ظل تلتجي ابفيه هاليتام
أگبل علينه اللّيل أو زادت الوحشة
اوما شوف غير أيتام تتصارخ ابدهشة
اوشيخ العشيرة احسين محّد شال نعشة
مطروح اوبجنبه عليّ الأكبر اوجسّام
(أبوذية)
|
يناعي صيح ابصوت وليان |
***
|
قم يا عليُّ فما هذا القعودُ وما |
المحاضرة الثالثة والعشرون: العفو
|
لعَمري لقد سَار الزمانُ بأهلهِ وما سيرُ هذا الدهرِ في النّاس راشدُ |
ولكن سلني ماذا يصنعن وهنَّ مربطات بالحبال على ظهور النياق المهزولة، وكأنّي بالنسوة:
|
هاي إتصيح أبويه إشلون خلاني |
***
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا﴾[426].
العفو وهو ضد الإنتقام، هو إسقاط ما يستحقه الغير من قصاص أو غرامة، وأيضاً هو محو الشيء وإزالته، ويقال: عفا عن الذنب، أي لم يعاقب عليه[427].
ولعلّ سائلاً يقول: ألا يُعتبر العفو عن الظالم المعتدي تأييداً لظلمه وتتميماً لنزعة العدوان لديه؟ ألا يؤدّي العفو إلى ظهور حالة سلبية من اللامبالاة لدى الظالمين؟
والجواب هو: إنّ العفو لا صلة لـه بمسألة تحقيق العدل ومكافحة الظلم؛ والدليل على ذلك ما تقرأونه في الأحكام الإسلامية من نهيٍ عن ارتكاب الظلم وأمر بعدم الخضوع لـه، كما في الآية المباركة: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾[428].
كما تقرأ من جانب آخر الأمر بالعفو والصفح، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾[429]، وقوله: ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾[430].
من الممكن أن يتبادر إلى الذهن أنَّ هناك تناقضاً بين هذين الحكمين، ولكن لدى الإمعان فيما ورد في المصادر الإسلامية في هذا المجال يتّضح أنّ العفو والصفح يجب أن يكون في موضعٍ بحيث لا يُساء استغلالُه، وإنّ الدعوة إلى مكافحة الظلم وقمع الظالم يكون لها مجالٌ آخر.
وينبغي أن يعلم بأنّ العفو والصفح يكونان لدى تملّك القدرة وعند الانتصار على العدو وهزيمته النهائية، أي في حال لا يحتمل فيها حصول أي خطر جديد من جانب العدو، ويكون العفو والصفح عنه سبباً لإصلاحه واستقامته ودفعه إلى إعادة النظر في سلوكه، والتاريخ الإسلامي فيه أمثلة كثيرة في هذا المجال وكلام مولى الموحدين× إذ قال: «إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه»[431]، خير دليل على هذا القول.
أمّا في حالة وجود خطر من جانب العدو، واحتمال أن يؤدّي العفو عنه إلى تجرّيه وتماديه أكثر في عداوته، أو إذا اعتبر العفو استسلاماً للظلم وخضوعاً أمامه ورضىً به، فإنَّ الإسلام لا يجيزُ مثل هذا العفو مُطلقاً ، كما أنَّ أئمّة الإسلام لم ينتخبوا طريق العفو في مثل هذه المجالات[432].
حيث إنّ الأئمّة^ اقتبسوا ذلك من أدب الله تبارك وتعالى، وهو غفور رحيم، وشديد العقاب في وقتٍ واحدٍ.
«وأيقنتُ أنّك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة»[433].
ثُمَّ لو رجعنا إلى الآية نجد أنَّها ليست عديمة الارتباط بما قبلها من الآيات، وبالخصوص الآية التي قبلها مباشرة، حيث قال تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا﴾[434] ثُمَّ جاء دور الآية التي نحن بصددها، فالآية المباركة ذكرت ثلاثة أُمور:
الأول: ﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا﴾ ومعنى الإبداء هنا هو الإظهار، أي إظهار الخير سواء كان فعلاً، كإظهار الإنفاق على مستحقّه، وكذا كلّ معروف؛ لما فيه من إعلاء لكلمة الدين وتشويق الفاسق إلى المعروف، أو كان قولاً، كإظهار الشكر للمنعم وذكره بجميل القول؛ لما فيه من حسن التقدير وتشويق أهل النعمة.
الثاني: ﴿أَوْ تُخْفُوهُ﴾، أي: أوتخفوا الخير، يعني فعل المعروف؛ ليكون أبعد من الرياء وأقرب إلى الإخلاص، كما قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾[435].
وأمّا الأمر الثالث والمهم في المقام: وهو العفو عن السوء، فالمقصود منه هو الستر عليه قولاً، بأن لا يُذكر ظالم بظلمه، ولا يذهب بماء وجهه عند الناس، ولا يُجهر عليه بالسوء من القول، وفعلاً، بأن لا يواجهه بما يقابل ما أساء به، ولا ينتقم منه فيما يجوز له ذلك[436].
فالعفو من المراتب السامية التي لا يتحلّى بها إلّا عباد الله المخلصون، وهو من آداب الله تبارك وتعالى التي أدّب بها النبيّ الأكرم’.
وللعفو فضائل لا تُعدّ ولا تُحصى؛ حتّى ورد عن النبيّ الأكرم’: «إذا عنت لكم غضبة فادرؤوها بالعفو، إنّه ينادي منادٍ يوم القيامة مَن كان لـه على الله أجرٌ فليقم، فلا يقوم إلّا العافون، ألم تسمعوا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾»[437].
فكفى به فضلاً ومنزلة أن يكون أجره على الله تبارك وتعالى، وهذا غاية ما يتمنّاه الإنسان.
وأفضل العفو وأجمله، هو العفو عند القدرة؛ حتّى ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي×: «أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة»[438].
ثمار العفو:
ثُمَّ إنَّ هنالك ثماراً عديدة للعفو، منها:
1 ـ سقوط الضغائن بين المتعافين لما روي عن رسول الله’ أنّه قال: «تعافوا تسقط الضغائن بينكم»[439].
2 ـ يزيد العبدَ عزّاً، لما ورد عنه’، أنّه قال: «عليكم بالعفو فإنّ العفو لا يزيدُ العبدَ إلّا عِزّاً فتعافوا يعزّكم الله»[440].
3 ـ يزيد في العمر، فعنه’ أنّه قال: «... مَن كثر عفوه مُدّ في عمره»[441].
4 ـ دفع عذاب النار؛ لما ورد عنه’ أنّه قال: «تجاوزوا عن ذنوب الناس يدفع الله عنكم بذلك عذاب النار»[442].
5 ـ يدفع سوء الأقدار؛ لما ورد عنه’ أنه قال: «تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يَقِكم الله بذلك سوء الأقدار»[443].
فمن هنا كان العفو دأب أهل البيت^، ومَن تتلمذ على أيديهم من أصحابهم، حتّى وصل الدور إلى أفذاذ العلماء أمثال العالم العَلَم الشيخ مرتضى الأنصاري الذي ينقل أحد أسباطه بالواسطة، أنّه شوهد رجل قد طرح بنفسه على قبر الشيخ الأنصاري وكان يبكي بكاءً شديداً.
وعندما سُئل عن سبب بكائه؟
قال: أوعز إليَّ جماعة أن أقتل الشيخ، فاستجبت لطلبهم، وأخذت سيفي وذهبت إلى منزل الشيخ وكان الوقت منتصف الليل، فلمّا دخلت عليه غُرفَتَه وجدتُه على سجادته في حالة الصلاة، فلمّا جلس رفعت السيف بيدي لأضربه، فامتنعت يدي عن الحركة ولم أتمكّن من القيام، فبقيت على هذه الحال حتّى فرغ من صلاته وبدون أن يرجع بطرفه إليّ قال: إلهي، ما الذي عملته حتّى أن فلان وفلان ـ وصرّح بأسمائهم ـ قد أرسلوا فلاناً ـ وصرّح باسمي ـ ليقتلني، إلهي، قد غفرت لهم فاغفر لهم.
وفي ذلك الوقت التمست منه وطلبت العفو، فقال لي: لا ترفع صوتك حتّى لا يفهم أحد، إذهب لمنزلك، وتعال لي عند الصباح.
فخرجت من عنده وقد استغرقت في الفكر حتّى الصباح، وعند الصباح فكّرت وقلت في نفسي أأذهبُ أم لا أذهب؟ وما الذي يحدث لي في حالة امتناعي عن الذهاب؟
وأخيراً تملّكت الجُرأة وذهبت، فرأيت الناس حوله في المسجد، فتقدمّت إليه، وسلّمتُ عليه، فأعطاني كيساً من المال في الخفاء، وقال لي: اذهب وتكسّب به، ومن بركة هذا المبلغ أصبحت اليوم أحد تجار السوق، وكلّ ما عندي هو مِن بركة صاحب هذا القبر.
وقد يسأل سائل ويقول: لماذا لا يتّفق مثل ذلك لأمير المؤمنين× حيث قتله ابن ملجم، وليس بعد أمير المؤمنين غير أولاده مَن يصل إلى مقامهم صلوات الله عليهم أجمعين؟!
الجواب: هي إرادة الله تبارك وتعالى، وفعلها وعدم فعلها تابع لمشيئته، كما أنَّ بدن الحسين× رضّته الخيل في كربلاء ولم تتمكّن الثيران من محو معالم قبره حينما أراد المتوكّل ذلك[444].
نعم رضّت الخيل الجسد الطاهر لإمامنا الحسين× بمسمعٍ ومرأى من أُمّ المصائب زينب‘، نظرت فرأت الخيل تلعب على صدر الحسين×، وكأنّي بها بلسان الحال تقول:
|
يا ناس ضيّعت البصيرة |
تســـوي الجــثّت ابـن أُمّـــي حـــفيرة
إلى أين تلتفت، وبأيِّهم تنتخي، بأبي الفضل العباس× وهو على نهر العلقمي جثّة بلا رأس.
(قطيفي)
سبع التنخّينه غده على الگاع طايح
سبع التنخّينه غده على الگاع طايح
ومنحور من ظلّوا على الغبره ذبايح
سبعين صرعه ما يسمعون الصوايح
ومحد من رجالچ بگه تترگبينه
واللّي يرد الخيل عنچ داسته الخيل
ظل عالثرة يمخدّرة من غير تغسيل
لازم يزينب تركبي ظهور المغافير
ومجلس الطاغي يزيد لازم تدخلينه
وين الكفيل اللّي زمطلچ بالكفالة
وجابچ لأراضي كربله بعزّ وجلاله
روحي النهر العلگمي واُنظري بحاله
گالت چفيلي مات وتوسّد يمينه
***
|
فديتُك لو تعاينُ ما أُلاقي |
المحاضرة الرابعة والعشرون: مَن هم أولوا الأمر
|
قِفْ بالطفوف وجُد بفيضِ الأدمُعِ |
(فايزي)
وگفت علی التل الحزينة إبگلب مفتوت
اوشبچت علی الراس بعشـرها اوصاحت بصوت
يحسـين دگعد وصلت العدوان البيوت
هجموا علينه يا كفيلي اوفرهدونـه
ناده لسان الحال منه وصعَّد أنفاس
يمخدرة حيدر أبونه صعب المـراس
كثر العتب شيفيد في جثه بلا راس
راسي علی الخطّي يزينب تنظرينه
ردي الخيمة گالت الخـيمة احرگوها
سلي الحرم گالت حريمك سلبـوها
باري اسكينه اعزيزتي لا يضـربوها
اوزين العباد البالمـرض منخطف لونـه
***
(نعي)
|
أوصيچ يازينب بلعيال اوعـينچ تحطيها من الأطفال |
ونــــظري علـــي الســـجّاد لـــومــال
وكأنّي بها تجيبه بلسان الحال:
(عاشوري)
|
ابـعيني لباريلك اعيالك |
***
قال تعالی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾[446].
لقد كثر النقاش والكلام حول المُراد من أُولي الأمر، ومايُعتبر فيهم من صفات، كما تشبّث بها الحُكّام الأدعياء في وجوب إطاعتهم، أوالسكوت عنهم علی الأقل[447].
ولأجل بيان الحقّ في الآية نذكر كلام المفسّرين وما قيل، أو يمكن أن يُقال. قال العلّامة الطباطبائي+: لمّا فرغ الله تبارك وتعالی من الندب إلی عبادته وحده لا شريك له، وبثّ الإحسان بين طبقات المؤمنين، وذمّ مَن يعيب هذا الطريق المحمود، أو صدّ عنه صدوداً، عاد إلی أَصل المقصود بلسان آخر، يتفرّع عليه فروع أُخری، بها يُحكم أساس المجتمع الإسلامي وهو التخصيص والترغيب في أخذهم بالائتلاف والاتّفاق[448].
واللازم هنا عرض الجهات التي تضمّنتها الآية والآراء التي قيلت حولها.
1 ـ لا يختلف اثنان من المسلمين في أنَّ طاعة الله والرسول إنّما تكون بالعمل بكتاب الله وسنّة نبّيهِ، وإنّهما وسيلتان للتعبير عن شيءٍ واحد ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾[449]،﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[450] وغيرها من الآيات الشريفة. ومن هنا اتَّفق المسلمون قولاً واحداً علی رفض كلّ ما يُنسب إلی النبيّ’ إذا تنافی مع مبدأ من مبادئ القرآن، أو حكم من أحكامه.
وقد يسأل سائل ويقول: لماذا كُرّر لفظ الإطاعة عند ذكر الرسول ولم يكرّرها عند ذكر أُولي الأمر؟ وهو سؤال مشروع.
الجواب: إنَّ تكرار (أطيعوا) في الآية المباركة إنّما هو للتنبيه علی أنّ طاعة الرسول أصل بذاته، تماماً كإطاعة الله، ومن هنا كان قول كلّ منهما مصدراً من مصادر الشريعة، وليس كذلك إطاعة أُولي الأمر؛ لأنّها فرع وتبع لإطاعة الله والرسول؛ لأنَّ أُولي الأمر فرع عن الرسول’ وطريقهم^ طريقه’.
ولذا ورد: «إنّ حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي رسول الله’»[451].
2 ـ إنّ لفظ منكم يدلُّ بوضوح ٍ علی أنّ حاكم المسلمينيجب أن يكون منهم ولا يجوز إطلاقاً أن يكون من غيرهم، ويؤيّد ذلك قوله تعالی: ﴿ولَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[452].
3 ـ اختلفوا في المُراد من أُولي الأمر ـ بعد اتّفاقهم علی شرط الإسلام ـ علی عدّة أقوال:
القول الأول:
ذهب جماعة من مفسّري أهل السنّة[453] إلی أن المراد من أُولي الأمر هم الأُمراء والحُكّام في كلّ زمان ٍ ومكانٍ، فتكون نتيجة هذا الرأي هي: أنّ علی المسلمين أن يُطيعوا كلّ حكومةٍ وسُلطة مهما كان شكلها حتّی إذا كانت حكومة المغول ودولتهم الجائرة.
وهذا الرأي لا يناسب مفهوم الآية وروح التعاليم الإسلامية بحالٍ؛ إذ لايمكن أن تقترن طاعة كلّ حكومة ـ مهما كانت طبيعتها ـ ومن دون قيد وشرطٍ بإطاعة الله والنبي، ولهذا تصدّی كبار علماء السُنّة لنفي هذا الرأي وهذا التفسير، مضافاً إلی علماء الشيعة.
القول الثاني:
ذهب البعض من المفسِّرين ـ مثل صاحب تفسير المنار وصاحب تفسير في ظلال القرآن وآخرون ـ إلی أنَّ المُراد من (أُولي الأمر) ممثّلو كافة طبقات الأُمَّة من الحكـّام والقادة والعلماء وأصحاب المناصب في شتّی مجالات الحياة، ولكن لا تجب طاعة هؤلاء بشكل مُطلق ٍ وبدون قيد أو شرط، بل هي مشروطة بأن لا تكون علی خلاف الأحكام والمقرّرات الإسلامية.
وهذا الرأي ـ كما تری ـ خلاف إطلاق الآية المباركة؛ لأنّ الآية توجب إطاعة أُولي الأمر من دون قيد أو شرطٍ.
القول الثالث:
ذهب جماعة آخرون إلی أنَّ المراد من (أُولي الأمر) هم القادة المعنويون والفكريون، أي: العلماء والمفكّرون العدول العارفون بمحتويات الكتاب والسنّة معرفة كاملة.
وهذا التفسير كسابقه لا يناسب إطلاق الآية؛ لأنّ لإطاعة العلماء واتّباعهم شروطاً من جملتها أن لا يكون كلامهم علی خلاف الكتاب والسنّة، وعلی هذا لو ارتكبوا خطأً ـ لكونهم عرضة للخطأ وغير معصومين ـ أو انحرفوا من جادّة الحقّ لأي سبب ٍ آخر لم تجب طاعتهم، في حين أن الآية توجب إطاعة أُولي الأمر بنحو مطلق كإطاعة النبيّ’.
هذا مضافاً إلی أنَّ إطاعة العلماء إنـّما هي في الأحكام التي يستفيدونها من الكتاب والسنّة، وعلی هذا لا تكون إطاعتهم شيئاً غير إطاعة الله وإطاعة النبيّ’ فلا حاجة إلی ذكرها بصورةٍ مستقلّةٍ.
القول الرابع:
وذهب بعض مفسِّري أهل السُنّة إلی أنَّ المُراد من هذه الكلمة هم الخلفاء الثلاثة مع أمير المؤمنين× الذين عبّروا عنهم بالخلفاء الأربعة، باعتبار أنّهم شغلوا منبر الخلافة بعد رسول الله خاصّة، ولا تشمل غيرهم، وعلی هذا لا يكون لأُولي الأمر أي وجود خارجي في العصور الأُخری!
وهذا الحصر لا دليل عليه، مضافاً إلی أنّه يؤدّي إلی عدم وجود مصداق لأُولي الأمر بين المسلمين في هذا الزمان.
القول الخامس:
إنّ (أُولي الأمر) هم صحابة الرسول الأكرم’.
القول السادس:
وهواحتمال يقول: بأنَّ المقصود من أُولي الأمر هم القادة العسكريون المسلمون وأُمراء الجيش والسرايا.
وهذان التفسيران ـ الخامس والسادس ـ لا يوجد أي دليل علی تخصيص الآية بهما، فالإشكال عليهما كالإشكال علی التفسير الرابع.
القول السابع:
ذهب كلُّ مفسِّري الشيعة (رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين) بالاتّفاق إلی أن المراد من (أُولي الأمر) هم الأئمّة المعصومون^، الذين أُنيطت إليهم قيادة الأُمَّة الإسلامية المادية والمعنوية في جميع حقول الحياة من جانب الله سبحانه وتعالی والنبيّ الأكرم’، ولا تشمل غيرهم. اللهمَ إلّا الذي يتقلّد منصباً من قبلهم، ويتولّی أمراً في إدارة المجتمع الإسلامي من جانبهم، فإنّه يجب طاعته أيضاً إذا توفرت فيه شروط معيّنة، ولا تجب طاعته لكونه من أُولي الأمر، بل لكونه نائباً لأُولي الأمر، ووكيلاً من قِبَلِهم.
وهذا التفسير يسلم من الإشكالات السابقة؛ وذلك لموافقته إطلاق وجوب الإطاعة المستفادة من الآية المبحوثة هنا؛ لأنّ مقام العصمة يحفظ الإمام من كلّ معصية، ويصونه عن كلّ خطأ، وبهذا الطريق يكون أمره ـ مثل أمر الرسول ـ واجب الإطاعة من دون قيدٍ أوشرط، وينبغي أن يوضع في مستوی إطاعته’، بل وإلی درجةٍ أنّها تُعطف علی إطاعة الرسول من دون تكرار أطيعوا.
والجدير بالانتباه إلی أنّ بعض العلماء المعروفين من أهل السنّة، ومنهم المفسِّر المعروف الفخر الرازي، قد اعترف بهذه الحقيقة في مطلع حديثه عند تفسير هذه الآية، حيث قال: «إنَّ الله تعالی أمر بطاعة أولي الأمر علی سبيل الجزم في هذه الآية، ومَن أمر الله بإطاعته علی سبيل الجزم والقطع لا بُدَّ أن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ، كان بتقدير إقدامه علی الخطأ قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهيٌّ عنه، فهذا يفضي إلی اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد.
ثبت أن الله تعالی أمر بطاعة أولي الأمر علی سبيل الجزم، وثبت أنّ كلَّ مَن أمر الله بطاعته علی سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ»[454][455].
ومع هذا الاعتراف الصريح والاستدلال المنطقي المتين ـ مع كثرة إشكالات صاحبه، حتّی تداول علی الألسنة بأنّه شيخ المشكّكين، أو مَن اعتاد الناس علی إشكالاته ـ قَبلَ دلالة الآية بهذا المقدار.
لكنَّ تلبيسَ إبليس وغوايته المعهودة لم تترك الفخر الرازي حتّی استدرك قائلاً:
«إنّنا عاجزون عن معرفة الإمام المعصوم والوصول إليه واستفادة الدين والعلم منه، فلا مناص من كون المراد هو أهل الحل والعقد»[456].
ولكن نسأل:
1 ـ هل أنَّ أهل الحلّ والعقد معروفون لدی الناس حتّی يرتفع الإشكال فهو تفسير بما هو أشدّ غموضاً من سابقه، فهل المراد منهم العساكر أو الضباط أو العلماء...؟
2 ـ إنَّ الآية إذا دلّت علی عصمة أُولي الأمر فيجب علينا التعرّف عليهم، وادّعاء العجز هروبٌ من الحقيقة، فهل العجز يختص بزمانه، أوكان يشمل زمان نزول الآية؟ والثاني باطل قطعاً، فإنّه لا يعقل أن يأمر الوحي الإلهي بإطاعة المعصوم، ثُمَّ لا يقوم بتعريفه حين النزول.
وإذا عرف في زمان النزول يُعرف في أزمنة متأخرة عنه حلقة بعد أُخری[457]، أضف إلی هذا كلّه ما ورد من الأحاديث في المصادر الإسلامية، تلك التي تؤيد تفسير (أُولي الأمر) بأئمّة أهل البيت^ منها:
1ـ ما كتبه المفسِّر الإسلامي المعروف أبو حيان الأندلسي المغربي المتوفي عام (756ﻫ) في تفسيره البحر المحيط: من أنَّ هذهِ الآية نزلت في حقِّ عليٍّ× وأهل بيته.
2ـ روی الشيخ سليمان الحنفي القندوزي وهو من أعلام أهل السُنّة المشهورين في كتابه (ينابيع المودة) من كتاب (المناقب) عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعتُ علياً× يقول: «أتاه رجلٌ فقال: أرني أدنی ما يكون العبد مؤمناً، وأدنی ما يكونُ به العبد كافراً، وأدنی ما يكون به العبد ضالاً؟
قال: قد سألتَ، فافهم الجواب... وأمّا أدنی ما يكون العبد به ضالاً أن لا يعرف حجّة الله تبارك وتعالی وشاهده علی عباده، الذي أمر الله} عباده بطاعته وفرض ولايته، قلتُ: يا أمير المؤمنين، صفهم لي. قال: الذين قرنهم الله تعالی بنفسه وبنبيِّه فقال: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.
فقلتُ له: جعلني الله فداك أوضح لي؟ فقال: الذين قال رسولُ الله’ في مواضع، وفي آخر خُطبة يوم قبضه الله} إليه: إنّي تركت فِيكم أمرين لن تضلوا بعدي إن تمسكتم بهما: كتاب الله} وعترتي أهل بيتي»[458].
3 ـ إضافة إلی كلّ ما تقدَّم ما رواه أفذاذ علماء الطائفة، أمثال ثقة الإسلام الكليني في الكافي الشريف، والعيّاشي في تفسيره، والصدوق في مصنفاته، وغير ذلك.
حتی أن صاحب تفسير البرهان السيد هاشم البحراني& ذكر ما يزيد علی عشر روايات في أنّها نزلت في أهل البيت^[459].
بلی والله، فهموا ذلك، وعلموا ولكن صَمُّوا عنه آذانهم فكانوا كالأنعام، بل أضل سبيلاً.
|
تبّاً لهم من أُّمةٍ لم يحفظوا |
من الذين دُسّ لهم السمّ، إمامنا زين العابدين×، حتّى أصبح يتقلّب من السُمّ الذي دسّه إليه الوليد (لعنه الله).
قال إمامُنا السجاد× ـ عند الوفاة ـ لأبي جعفر الباقر×:
«إني حججتُ علی ناقتي هذه عشرين حجّة لم أقرعها بسوطٍ فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع، فإنَّ رسول الله’ قال: ما من بعير يُوقف عليه موقف عرفة سبع حجج إلّا جعله الله من نعم الجَنّة وبارك في نسله».
فلمّا دُفن الإمام زينُ العابدين× فلم تلبث أن خرجت الناقة إلی القبر فضربت بجرانها[460]الأرض، ورغت رغاءً عالياً وهملت عيناها، فأُخبر بذلك الباقر× فجاء إليها وقال لها: «مه الآن وقومي»، فقامت ودخلت موضعها فما مضت إلّاهنيئةً إذ خرجت الناقة ثانية، ورغت رغاءً عالياً وضربت بجرانها القبر وهملت عيناها، فأُخبر الباقر×، فقال×: «دعوها فإنّها مودِّعة»، فلم تلبث إلّا ثلاثة أيامٍ حتّی نفقت وماتت، فأمر الإمام الباقر× بدفنها فدُفنت[461].
أقول: وأعجبُ ممّا فعلته هذه الناقة ما فعله جواد الحُسين× يوم عاشوراء وماذا فعل الجواد؟ جعل يشمّ الحُسين عرفه ويلطخ ناصيته بدم الحُسين وتوجّه نحو الخيام وهو يقول بصهيله: الظليمة الظليمة من أُمَّةٍ قتلت ابن بنت نبيها، فلمّا وصل إلی خيمة النساء جعل يضرب برأسه الأرض عند باب الخيمة، ولم يزل يضرب حتّی مات، وإليه أشار الإمام الحجّة# في زيارة الناحية:
«فلمّا نظرت النساء إلی الجواد مخزيّاً والسرج عليه ملويّاً، خرجن من الخدور ناشرات الشعور علی الخدود لاطمات وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات وبعد العزّ مذللات وإلی مصرع الحُسين مبادرات».
فواحدة ٌ تحنو عـليه تشـمّه |
ولسان حال العقيلة‘:
|
بسما غبت واگفيت يحسين |
ولذا تقول يالثارات الأئمّة الهُداة:
|
آه نطلب ثار رضّة الباب |
***
ما ذنب أهل البيت |
المحاضرة الخامسة والعشرون: الحقّ والباطل
|
أبا حسـنٍ تُغضـي وتلتـذُّ بالكرى |
(فائزي)
يلّي تنـاشـدني عليمَن تهمـل العـين
كلّ البچه والنوح والحسـره على احسين
حُبّه ابگلبي اوتظهره ابصبها ادموعي
مجبـور في حُبّـه ولا اشوفه ابـطـوعي
يا ريت گبل اضلوعه أنرضّت اضلوعي
اومن دون خـده إتعفّرت منّي الخـدّين
أبچي على مصابه كلّ صبح اومسيه
أبچي وساعد عالبچه الزهره الزچيه
لا زال تنـدب يا غـريب الغـاضـريه
يحسين وين اللي يواسيني عله احسين
(أبوذية)
|
ابگلبي مأتمك يحسين ينصاب |
***
قال تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[464].
الحقّ: هو الصدق واليقين والشيء الثابت بلا شك.
والباطل بخلافه، فهو الفاسد والساقط.
وهُناك فاصلة بين الحقّ والباطل أشار إليها الإمام الباقر× في رواية عن الإمام أمير المؤمنين×، حيث قال:« سُئل أمير المؤمنين× كم بين الحقّ والباطل؟
فقال: أربعُ أصابع ـ ووضع أمير المؤمنين يده على أذنه وعينه ـ فقال: ما رأتهُ عيناك فهو الحقّ، وما سمعته أذناك فأكثره باطل»[465].
فمن هنا لا بدّ للإنسان أن يتحذّر في كلامه وأحكامه التي يتّخذها على الإنسان الآخر، ويكون منصفاً في اتّخاذها، ولا يدع اللامبالاة هي الحاكمة عليه من دون أن ينظر بعين الإنصاف إلى الناس.
قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾[466].
ولذا ترى أن الإمام× يقول ما بين الحقّ والباطل أربع أصابع.
وفي كلمة غرّاء أُخرى له× أنّه قال: «الحقّ طريق الجَنّة، والباطل طريق النار، وعلى كلّ طريق داعٍ...»[467].
فبعض الناس دائماً وأبداً يسعون للحقّ، والبعض الآخر بخلافهم دائماً وأبداً يسعون للباطل، بل ثانون أرجلهم؛ ليصدّوا عن الحقّ وعن الطريق السوي.
ومن هنا روي عن الإمام أبي عبد الله الصّادق× أنّه قال: «إنّ الله} خلق قوماً للحقّ، فإذا مرّ بهم الباب من الحقّ قبلته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه، وإذا مرّ بهم الباطل انكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه، وخلق قوماً لغير ذلك فإذا مرَّ بهم الباب من الحقّ أنكرته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه، وإذا مّر بهم الباب من الباطل قبلته قلوبهم وإن كانوا لا يعرفونه»[468].
من بعد هذه المقدِّمة نأتي للآية.
لا شكَّ أنَّ الآية جاءت في سياق آياتٍ عديدة تناولت عدّة أُمُور من أوامر ونواهي لبني إسرائيل، ولعلّها تزيد على مائة أمر من هذا القبيل إلى أن وصل الدور إلى هذا المقطع وهو نهي هنا.
رُوي عن الإمام العسكري× أنّه قال: «خاطب الله بها قوماً من اليهود ألبسوا الحقّ بالباطل بأن زعموا أنّ محمّداً نبيٌّ وأنَّ عليّاً وصيٌّ، ولكنّهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة، فقال لهم رسول الله’: أترضون التوراة بيني وبينكم حكَماً؟ فقالوا: بلى، فجاؤوا بها وجعلوا يقرؤون منها خلاف ما فيها، فقلب الله} الطومار[469] الذي كانوا يقرؤون فيه، وهو في يد قرّاءين منهم مع أحدهما أوّله ومع الآخر أخره، فانقلب ثعباناً له رأسان، وتناول كلّ رأس يمين مَن هو في يده وجعل يُرضُضه ويُهشّمه ويصيحُ الرجلان ويصرخان، وكانت هناك طوامير أُخرى فنطقتْ وقالت: لا تزالا في هذا العذاب حتّى تقرءا بما فيها من صفة محمّد’ ونبوّته وصفة عليٍّ× وإمامته على ما أنزل الله تعالى، فقرءا صحيحاً وآمنا برسول الله’ واعتقدا إمامة علي ولي الله ووصيِّ رسول الله’، فقال الله: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ﴾ بأن تقرّوا لمحمد’ وعلي× من وجهٍ وتجحدوهما من وجه، بأن ﴿ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ﴾ من نبوة محمّد هذا وإمامة علي هذا ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنّكم تكتمونه وتكابرون علومكم وعقولكم، فإنّ الله إذا كان قد جعل أخباركم حجّة، ثُمَّ جحدتم لم يُضيّع هو حُجته، بل يقيمها من غير حجّتكم فلا تقدروا أنّكم تغالبون ربكم وتقاهرونه...»[470].
وقضية كتمان الحقّ ولبسه بالباطل، ولا هي من مستحدثات عصرنا هذا، بل هي تجري في دم بني إسرائيل ومَن شاكلهم من ذاك الزمان إلى وقتنا هذا.
نقل أحدُ المبشّرين النصارى قصّة اعتناقه للإسلام الحنيف، فقال: بعد سفر طويل في العلوم والمعارف المسيحيّة، انتقلت إلى إحدى المدارس الكاثوليكية وكان يُديرها قِسّ مُقرّب إلى أوساط الأعيان والأشراف، وكان متميّزاً في التدريس لا يقل حضّار درسه عن خمسمائة طالب، مضافاً إلى عدد آخر من الراهبات، ولقد نشأت بيني وبينه علاقة ودّ حميمة، بحيث اطمأنَّ لي وسلّمني مفاتيح غرف الكنيسة، ما خلا مفتاحاً واحداً لغرفة صغيرة كنت أظنّها مخصصة للذهب والمجوهرات، وفي أحد الأيام، أمرني أستاذي القسّ بالذهاب إلى الطلاب، وإبلاغهم اعتذاره عن حضوره للتدريس، ولمّا وصلت قاعة الدروس وجدتهم يتباحثون فيما بينهم لفظ (فارقليط) الذي ورد في إنجيل يوحنا في الإصحاحات [14 ـ 15 ـ 16] بعد أن استمعت إلى مناقشتهم واحتجاجهم، عدت إلى الأُستاذ وأخبرته بما دار بينهم حول العبارة وتفاسيرها.
قال لي الأُستاذ: وما تقول أنت؟ فذكرتُ له رأي أحد مفسِّري الإنجيل.
قال الأُستاذ: ليس التقصير منك، إنّ تفسير هذا اللفظ لا يعرفه في هذا الزمان غير فريق ضئيل من أصحاب الرأي والتحقيق في هذا العلم.
شعرت أنَّ في الأمر سرّاً يخفى عليَّ، ألقيتُ بنفسي على قدميه وتوسّلت إليه أن يُطلعني على المراد الحقيقي. اغرورقت عيناه بالدموع، ثُمَّ استرسل في البكاء، وبعد برهة رفع عينيه المبلّلتين نحوي وقال: سوف أذكر لك الحقيقة شريطة أن تبقيها سرّاً بيننا ما دمتُ على قيد الحياة؛ لأنّك إن أفشيتها تكون قد حكمتَ عليَّ بالإعدام.
وبعد أنْ عاهدتُه على الالتزام بما طلب، نظر في وجهي لحظات ثُمَّ قال: إنَّ (فارقليط) هو اسم نبيّ الإسلام، ويعني كثير الحمد (أحمد ومحمد).
ثمَّ ناولني مفتاح تلك الغرفة، التي كنت أظن أنّها مخصّصة للذهب والمجوهرات، وقال لي: افتحها وسوف تجد فيها صندوقاً بموضع كذا، وفي الصندوق كتابان قد كُتبا على جلود الحيوانات، وقد كُتبا بالخط اليوناني قبل ظهور الإسلام، احضرهما وسترى بعينك تفسير (فارقليط) بما ذكرتُ لك.
يقول ذلك القسّ التلميذ: ومُنذ تلك اللحظة تمكّن عشقُ الدين الإسلامي من قلبي وأيقنت أنّ واجبي هو دعوة الناس إليه.
وبعد إشهار إسلامه، أطلق على نفسه اسم (محمّد صادق فخر الإسلام)، وألّف كتاباً في رد المسيحيين ويروي فيه قصّة إسلامه، بعنوان (أنيس الأعلام)[471]. وقد طبع الكتاب مؤخّراً في ستّة أجزاء[472].
إذن، لبس الحقّ بالباطل من لباس اليهود وتلاميذهم؛ ولذا أكّدت عليه الآية تأكيداً حثيثاً.
فقالت: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
فإضلال الغير يحصل بأحد طريقين: وذلك لأنّ الغير إمّا أنّه سمع دلائل الحقّ، وإمّا أنّ الغير لم يسمع دلائل الحقّ.
فعلى الأول يكون إضلاله بتشويش تلك الدلائل عليه، وعلى الثاني فإضلاله إنّما يمكن بإخفاء تلك الدلائل عنه، ومنعه من الوصول إليها، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ إشارة إلى تشويش الدلائل عليه، أو منع وصول الدلائل إليه.
وقوله: ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ﴾ إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل.
والكلام وإن كان موجهاً إلى بني إسرائيل، ولكن هو تنبيه إلى سائر الخلق وتحذير مَن مثله، فصارَ الخطابُ وإن كان خاصّاً في الصورة لكنّه عامٌّ في المعنى[473].
فعلى طول التاريخ يجرى لبس الحقّ بالباطل وكتم الحقّ مع العلم به جزماً، فترى أُمّةً من الناس وبكلّ صلافة يخلطون السمَّ بالعسل، من زمن النبيّ الأكرم’ وما بعد زمنه’ ترى هذا الخلط، إلى أن وصل بهم الأمر أن يسبّوا عليّاً×، بل أكثر من ذلك إذ أنّ لبس الحقّ بالباطل الذي وصل به معاوية إلى ذروته جعل الناس يُصدّقون بأنّ أمير المؤمنين× لا يصلّي، وذلك عندما انتشر خبر شهادته في المحراب، قالوا: ولِمَ في المحراب؟ قيل: لأنّه كان يصلي صلاته فيه.
قالوا: عجباً أوَ يصلي ابن أبي طالب؟!
هكذا وصل الأمر بالناس، منع معاوية وصول الحقائق إليهم، بل حتّى الذين وصلت إليهم الحقائق استطاع بمكرهِ وخداعه وكذبه أن يُشوّش تلك الحقائق، فكان مصداقاً حقيقياً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
فألبس الحقّ بالباطل بتشويشه أفكار الناس، وكتم الحقّ أن يصل إلى الناس، والحقّ مع علي بن أبي طالب× كما جاء في أكثر من حديث عن النبيِّ الأعظم’: «عليّ مع الحقّ، والحقّ مع عليّ»[474]، «عليّ مع القرآن، والقرآن مع عليّ لا يفترقان»[475]، إلى غير ذلك من المضامين الصريحة.
ولكنّه غيّر عقول الناس ، فمثلاً: في قتل عمار بن ياسرE مع أنّه وردت أحاديث متواترة في أنّ عمّار تقتله الفئة الباغية[476]، ولكن ترى كيف أنّ معاوية ألبس على الناس الحقّ؟! عندما قُتِل عمّار يوم صفين ماج أهل الشام بقتله لهذا الحديث؛ إذ كان معلوم التواتر، فموّه عليهم معاوية وقال: قاتله الذي جاء به من العراق وألقاه بين رماحنا ـ يعني به علياً×ـ فقال الإمام×: «يلزم على هذا أن يكون النبي’ قاتل عمّه حمزة؛ لأنّه ألقاه بين رماح المشركين»[477].
وهكذا في تفسير معركة صفين عندما أمر الجيش بأن يرفعوا القرآن على الرماح بعد أن أوشكت الهزيمة أن تقع بهم، فقال الإمام علي×: «كلمة حقّ يُراد بها باطل»[478].
معنى ذلك أن نفس القرآن حقّ، لكن رفعه في هذا الوقت وفي هذه الساعة ما أُريد به إلّا الأباطيل والحِيَل.
وهناك الكثير ممّا قام به معاوية وأضرابه؛ ولذا ترى تلاميذ معاوية صنعوا كما صنع معاوية، وأقرب هؤلاء التلاميذ المخلصين لمعاوية ابنه يزيد قاتل الحسين×.
فقد زاد على أبيه وشيطنته، وألبس الحقّ بالباطل وكتم الحقّ عن الناس، حيث أشاع بين الناس بأنّ الحسين خارج على إمام زمانه.
يقول مسلم الجصّاص: دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة فبينا أنا أجصّصُ الأبواب وإذا بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، فأقبل عليَّ خادمٌ كان معنا، فقلت: ما لي أرى الكوفة تضجُّ؟ قال: الساعة يؤتى برأس خارجي خرج على يزيد.
فقلت: مَن الخارجي؟
فقال: الحسين بن عليّ.
قال مُسلم: فتركت الخادم حتّى خرج، لطمت وجهي حتّى خشيت على عينيَّ أنْ تذهبا، وغسلت يديَّ من الجصّ، وخرجتُ من ظهر القصر، وأتيت على الكناس، فبينا أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس وإذا بالمحامل نحو ثمانين شُقّة على أربعين جملاً، فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة الزهراء، وإذا بعليِّ بن الحُسين على بعير بغير وطاء، وأوداجه تشخب دماً.
وا حزناه على بنات رسول الله، وا ويلاه على زين العابدين.
والذي عظم على زين العابدين وبنات رسول الله: أنَّ نساء الأنصار اللاتي كُنّ مع السبايا لمّا وصلنَ إلى الكوفة تشفّع فيهّنَّ بعضُ أرحامهن فأمر ابن زياد بتسريحهن، وبقيتْ بناتُ رسول الله’[479]، وكأنّي بالحوراء زينب تخاطب الحسين عندما رأت ذلك:
|
يحسـين كـلّ إلهه عشـيره |
مـــا من عشـيرتهن ذخــــيره
|
يهلنه ما دريتوا ابعملة احسين |
تطــــلـعـون مسبية النساويـن
***
(أبوذية)
|
المرض والگيد للسجّـاد باريه بآيةِ أهلِ الكهفِ راحَ يُردّدُ |
المحاضرة السادسة والعشرون: التوكّل
|
أوَ مَا أتاكَ حديثُ وقعةِ كربلا |
***
|
ذيچ إسا أريديچ تعذريني |
***
|
لكن يلعقيله لومشه احسين |
***
قال الله في محكم كتابه الكريم: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾[481].
هو اعتماد القلب على الله في الأُمور كلّها وانقطاعه عمّا سواه، فما فعل بك كنت راضياً تعلم أنّ الحكم في ذلك له وتُسلّم أنَّ ما جاء من الأوامر والنواهي هو خير لك، وتعمل بها من دون عنادٍ وكرهٍ.
قال ابن الأثير : «توكّل بالأمر، إذا ضمن القيام به. ووكّلت أمري إلى فلان: أي ألجأته إليه واعتمدتُ فيه عليه. ووكّل فلان فلاناً، إذا استكفاه أمره ثقةً بكفايته، أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه»[482]، وينبغي للمؤمن أن يجعل نفسه بين يدي الله تعالى، يفعل بها ما يشاء، ولكنَّ الحركة في طلب الرزق لا تنافي التوكّل؛ لأنَّ الله أمر بها بقوله تعالى: ﴿فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ﴾[483].
ومن هنا فلا يعترض البعض بأن يجلس في داره مدَّعياً التوكّل على الله في أن يرزقه، فإنّ مثل هذا ليس من التوكّل، وإنّما التوكّل والاعتماد على الله تبارك وتعالى إنّما يكون مع العمل ومع السعي والجدِّ والمثابرة والعزم، قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾[484].
ومن هنا نجد أنَّ النبيّ الأكرم’ نهى الأعرابي لمّا أهمل بعيره وقال: «توكّلت على الله، قال له’ اعقلها وتوكّل»[485]. أي: اربط البعير وتوكّل على الله.
وسأل رسول الله’ جبرائيل: «ما التوكّل على الله} فقال: العلم بأنّ المخلوقَ لا يضر ولا ينفعُ، ولا يُعطي ولا يمنعُ، واستعمال اليأس من الخلق، فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله، ولم يرجُ ولم يخف سوى الله، ولم يطمع في أحد سوى الله، فهذا هو التوكّل»[486].
هناك عدّة نتائج وثمرات مترتّبة على التوكّل، أشارت إليها بعض الأحاديث والروايات التي وردت عن المعصومين^ منها:
1 ـ الشعور بالقوّة والهمّة؛ لأنّ التوكّل على الله مع العمل يجعل الإنسان يشعر أنّه أدّى ما عليه، فيكون قوي القلب بقوّة الله}.
2 ـ المتوكّل يكون عزيزاً وغنّياً بين الناس.
3 ـ مَن توكَّل على الله ذلّت له الصعاب وتسهّلَتْ عليه الأسباب.
فعن النبيّ الأعظم’: لو أنّ رجلاً توكَّل على الله بصدق النية لاحتاجت إليه الأُمراء فمَن دونهم، فكيف يحتاج هو ومولاه الغني الحميد[487].
فإذا توكّل الإنسان على الله تبارك وتعالى كفاه الله أُموره كلّها، حيث قال تبارك وتعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾[488].
ولذا يُحكى أنّه في إحدى المدن كان هناك تاجر مؤمن يتوكّل على الله دائماً، خصوصاً فيما يتعلّق بتجارته وتعامله مع القوافل، وبسبب ذلك التوكّل لم تتعرّض تجارته للسرقة من اللصوص وقطّاع الطرق الموجودين بكثرة خارج المدينة، فأراد أصحابه أن يؤذوه يوماً ما عندما خرجوا جميعاً للتجارة، فحينما نام التاجر المؤمن أخذوا بضاعته ودفنوها في الصحراء، حتّى إذا أصبح الصباح قالوا له: إنّ بضاعتك قد سرقها اللصوص، ولكن وبعد أن انتهوا من عملهم وذهبوا للنوم هجم قطاع الطرق على القافلة وسرقوا كلّ ما كان لديهم من بضاعة، ولم يأخذوا بضاعة الرجل المؤمن؛ لأنّهم لم يكونوا يعرفون مكانها، وعندما أصبح الصباح أخذ الرجل بضاعته حامداً شاكراً لله تعالى متوكّلاً عليه[489].
ثُمَّ إنّ الكلام في الآية موجّه إلى الجميع، حيث يقول تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾، فلا تتصوروا أنّه سيبقى لكم؛ لأنّه كالوميض الذي يبرق ثُمَّ يخبو، وكالشمعة في مهبِّ الريح، والفقاعة على سطح الماء، ولكن ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ ﴾، فلو استطعتم أن تستبدلوا هذا المتاع الدنيوي الزائل المحدود التافه بمتاعٍ أبديٍ خالد، فتلك هي التجارة المربحة العديمة النظير.
فالمواهب في هذه الدنيا لا تخلو من المشاكل، حيث توجد الأشواك دائماً إلى جانب الورود، والمحبّطات إلى جانب الآمال، في حين أنَّ الأجر الإلهي لا يحتوي على أي إزعاجات، بل هو خير خالص ومتكامل.
ومِن جانبٍ آخر فإنّ هذه المواهب مهما كانت، ستزول حتماً، إلّا أنّ الجزاء الأُخروي أبدي خالد، عندها هل يقبل العقل أن يستغني الإنسان عن هذه التجارة المربحة، أو يصاب بالغرور والغفلة وتبهره زخارف الدنيا؟
إذن، لا قيمة للدنيا بالنسبة للآخرة؛ ولذا فقد رُوي عن النبيّ الأكرم’ أنّه قال: «والله، ما الدنيا في الآخرة إلّا مثل أن يجعل أحدُكم إصبعه هذه في اليّم، فلينظر بمَ ترجع»[490].
والملفت للنظر أنّه ورد في هذه الآية التأكيد على الإيمان والتوكّل، وهذا بسبب أن نَيل الأجر الإلهي هو للّذين يفوّضون أُمورَهم في جميع الأعمال، ويستسلمون له تعالى إضافة إلى الإيمان؛ لأنّ التوكّل يعني تفويض الأُمور. ويقابل هذه المجموعة أشخاص يجادلون في آيات الله بسبب حبّ الدنيا والارتباط بالمتاع الزائل ويقلبون الحقائق[491]، بل يحاولون إخفاء الحقّ عن أقرب الناس إليهم.
ولذا نرى يزيد (لعنه الله) قلب جميع الحقائق، قَتل أولاد النبيّين وأدخلهم إلى الشام على هيئة السبايا، ظانّاً بأنّه سوف يخفي الحقيقة أبداً، ولكنَّ الله تبارك وتعالى أبى إلّا أن يُظهر نورَه ولو كره المشركون.
أخفى الحقائق حتّى على زوجته هند، وهي ممَّن قُتل أبوها وبقيت عند الإمام أمير المؤمنين×، ولمّا قُبض أميرُ المؤمنين× بقيت في دار الحسن×، فسمع بها معاوية فأخذها من الحسن وزوّجها من ولَده يزيد، فبقيت عند يزيد إلى أن قُتل الحسين×، ولم يكن لها عِلم بأن الحسين× قد قُتل، ولمّا قُتل وأتوا بنسائه وبناته وأخواته إلى الشام، دخلت امرأة على هند وقالت لها: يا هند، الساعة أقبلوا بسبايا ولم أعلم من أين هم، فلعلك تمضين إليهم وتتفرجين عليهم، فقامت هند ولبست أفخر ثيابها وأمرت خادمة لها أن تحمل الكرسي، فلمّا رأتها الطاهرة زينب التفتت إلى أُختها أُمّ كلثوم، وقالت لها: أُخيّة أتعرفين هذه الجارية؟ قالت لا والله، قالت: هذه هند بنت عبد الله خادمتنا، فسكتت أُمّ كلثوم ونكَّست رأسها. فقالت هند: أراكِ طاطأت رأسكِ؟ فسكتت زينب ولم ترد عليها جواباً، ثُمَّ قالت لها: أُخيّة من أي البلاد أنتم؟ فقالت لها زينب: من بلاد المدينة، فلمّا سمعت هند بذكر المدينة نزلت من الكرسي، وقالت: على ساكنها أفضل السلام، ثُمَّ التفتت إليها زينب وقالت: أراك نزلت عن الكرسي؟
قالت هند: إجلالاً لمَن سكن في أرض المدينة، ثُمَّ قالت لها: أُخَيَّة أريد أن أسألك عن بيت في المدينة، قالت لها العقيلة زينب: اسألي ما بدا لك. قالت هند: أسألك عن دار علي بن أبي طالب×. قالت لها زينب: وإنَّ لكِ معرفة بدار علي؟ فبكت وقالت: إنّي كنت خادمة عندهم. قالت لها زينب: وعن أيّها تسألين؟ قالت أسألك عن الحسين وإخوته وأولاده وعن بقيّة أولاد علي، وأسألك عن سيدتي زينب، وعن أختها أُمّ كلثوم، وعن بقيّة مخدرات فاطمة الزهراء‘؟
فبكت عند ذلك زينب بكاءً شديداً، وقالت لهند: أمّا إن سألتِ عن دار علي× فقد خلفّناها تنعى أهلها، وأمّا إن سألتِ عن العبّاس وبقيّة أولاد علي، فقد خلفناهم على الأرض مجزّرين كالأضاحي بلا رؤوس، وإن سألتِ عن زين العابدين× فها هوعليل نحيل لا يُطيق النهوض من كثرة المرض والأسقام، وهذه أُمّ كلثوم، وهذه بقية مخدرات فاطمة الزهراء، وإن سألت عن زينب فأنا زينب بنت علي:
|
أنه زينب اليحچون عني |
(فايزي)
زينب تجاوبها اوگلبها فسـّره الهم
يالتنشدين احسين جسمه ابكربله تم
والراس جابوه إليزيد اوهاي چلثم
وآنه الذي ابخدري الوادم تضـرب أمثال
يا هند خلصت كلّ عمامي بأرض الطفوف
وعباس ظل جسمه بلا راس ولا اچفوف
ما چنت أظن من بلد لاخر بالسبي انطوف
اوتتفرج اعلينه الخلگ ما خطر علبال
فلمّا سمعت هند هذا الكلام ـ كلام زينب ـ رقّت وبكت ونادت: وا إماماه، وا سيداه، وا حسيناه، ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء ولا أنظر بنات فاطمة الزهراء على هذه الحالة.
ثُمَّ تناولت حجراً وضربت به رأسها، فسال الدم على وجهها ومقنعتها وغشي عليها، فلمّا أفاقت من غشيتها قيل: فقامت وحسرت وشققت الثياب وهتكت وخرجت حافية إلى يزيد وهو في مجلس عام، وقالت: يا يزيد أنت أمرت برأس الحسين يُشال على الرمح عند باب الدار؟ رأس ابن فاطمة بنت رسول الله’ مصلوب على فناء داري، فوثب إليها يزيد فغطّاها، فقالت: يا يزيد أخذتك الحميّة عليَّ فلِمَ لا أخذَتْكَ الحميّة على بنات رسول الله؟ هتكتَ ستورهنَّ وأبديتَ وجوههنَ، وأنزلتهن في دار خربة؟ والله، لا أدخل حرمك حتّى أدخلهن معي. وفعلاً أدخلتهن دارها بموافقةٍ من يزيد، فاقمن المآتم ثلاثة أيام.
(أبوذية)
|
سهر بالعين يوم احسين ورّث |
***
|
أوصى النبيُّ بوصلِ عترةِ أحمدٍ |
المحاضرة السابعة والعشرون: الرجاء والخوف
|
حُرِمَ السِبطُ من فراتٍ مبـاحِ |
***
وكأنّي بها‘ توجّه خطابها لأخيها أبي الفضل العباس×:
|
ينور العين منته اللي جبتني |
ولسان حاله×:
|
تعتبـين يا زينب علـيَّ |
روي عن إمامنا الصّادق×: أنّه قال: «ارجُ الله رجاءً لا يجرّئك على معاصيهِ وخفِ الله خوفاً لا يؤيسك مِنْ رحمتِه»[494].
الرجاء: هو توقّع الشيء المحبوب ولا معنى له إذا لم يكن عن عمل، فمَن رجا شيئاً طلبه وسعى إليه، فمَن رجا الجنّة سعى إليها بالعمل الصالح.
وأمّا الخوف: فهو التألّم من توقّع مكروهٍ ممكن الحصول أو عدم الحصول. والخشية والوجل والرهبة والهيبة، كلّها من أنواع الخوف.
قال تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾[495].
وهناك خوف ممدوح: وهو الخوف من الله ، والخوف من ارتكاب الذنوب، والخوف من التقصير في أُمور دينه وطاعته. وهذا الخوف يدعو الإنسان إلى السعي في طاعة الله، واجتناب معاصيه.
وأمّا الخوف المذموم: فهو الخوف من الأُمور الواقعة لا محالة وليس للإنسان القدرة على دفعها، مثل الخوف من الموت.
فلا بُدّ من إعمال توازن للخوف والرجاء، بأن لا يرجّح أحدهما على الآخر، ومن هنا ورد مرويّاً عن النبيّ الأكرم’ أنّه قال: «لو تعلمون قدر رحمة الله لاتَّكلتم عليها وما عملتم إلّا قليلاً، ولو تعلمون قدر غضب الله لظننتم بأن لا تنجوا»[496].
ثُمَّ إنّ الخوف يزداد بقدر معرفة الإنسان وعلمه، فكلّما كان الإنسان عالماً لا بُدّ أن يزداد خوفُه وعملُه، خوفه من الله، وعمله إلى الله}.
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾[497].
وما ورد عن نبيّ الرحمة’ أنّه قال: «مَن كان بالله أعرف كان من الله أخوف»[498].
ويروى أنّ نبيَّ الله عيسى (على نبينا وآله وعليه السلام): «مرّ بثلاثة نفر قد نحلت أبدانهم، وتغيّرتْ ألوانُهم، فقال لهم: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟
فقالوا: الخوف من النار. فقال: حقّ على الله أن يؤمنَ الخائف. ثُمَّ جاوزهم إلى ثلاثةٍ آخرين فإذا هم أشدّ نحولاً وتغيّراً، فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟
قالوا: الشوق إلى الجنّة. فقال: حقّ على الله أن يُعطيكم ما ترجون، ثُمَّ جاوزهم إلى ثلاثةٍ آخرين فإذا هم أشدّ نحولاً وتغيّراً كأنَّ على وجوههم المرايا من النور فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟
فقالوا: نحبُّ الله}. فقال: أنتم المقرّبون، أنتم المقرّبون»[499].
ثمَّ إنَّ للخائفين والراجين الله تعالى من الصفات ما يعرفون بها، وليس كلّ إنسان يمكن له أن يدّعي بأنّه خائف أو راجٍ، ومن هذه الصفات:
الأُولى: الهروب من الذنوب والمعاصي؛ لأنّ الذنوب تدخل العبدَ النارَ. والخائف خائف من عقوبات الله تعالى، وهي التي تتمثّل بدخول الإنسان إلى النار، والراجي كذلك، فإنّه يرجو رحمة الله، ويرجو الجنّة، وهي متمثّلة بالهروب من المعاصي، والطاعة لله تبارك وتعالى.
الثانية: يطلب دائماً الأعمال التي تقرّبُه إلى الله، ويختار الشاقّ منها؛ لما ورد «أفضل الأعمال أحمزها»[500] بمعنى أشقَّها.
الثالثة: يحاسب نفسه دائماً ويصلح عيوبه.
الرابعة: لا يخاف إلّا الله حتّى أنّه روي عن الرسول الأعظم’ أنّه قال: «مَن خاف الله خاف منه كُلّ شيءٍ، ومَن لم يخف الله أخافه الله من كلّ شيء»[501].
ولذا ترى أنّ المعصوم × لا يخاف من شيء؛ لأنّه خاف من الله تبارك وتعالى.
روي أنّه خرج الإمام موسى بن جعفر× في بعض الأيام من المدينة إلى ضيعة له خارجة عنها، فتبعته ـ الراوي ـ وكان راكباً على بغلةٍ وأنا على حمار، فلمّا صرتُ إلى بعض الطريق اعترضنا أسدٌ فأحجمتُ خوفاً، وأقدم أبو الحسن× غير مكترثٍ، به فرأيتُ الأسدَ يتذلّل لأبي الحسن× ويُهمهم، فوقف له أبو الحسن× كالمصغي إلى همهمته ووضع الأسد يده على كفل بغلته وخفتُ من ذلك خوفاً عظيماً، ثُمَّ تنحّى الأسد إلى جانب الطّريق وحوّل أبو الحسن× وجهَه إلى القبلة، وجعل يدعو، ثُمّ حرّك شفتيه بما لم أفهمه، ثُمَّ أومأ إلى الأسد أن أمضِ، فهمهم الأسد همهمةً طويلة، وأبو الحسن× يقول: آمين آمين، وانصرف الأسد حتّى غاب عن أعيننا ومضى أبو الحسن× لوجهه واتّبعته، فلمّا بعدنا عن الموضع لحقته، فقلت لـه: جعلت فداك ما شأن هذا الأسد؟ ولقد خفته والله عليك وعجبت من شأنه معك. فقال لي أبو الحسن×: «إنّه خرج إليّ يشكو عسر الولادة على لبوته، وسألني أن أدعو الله ليفرِّجَ عنها، ففعلت ذلك وألقي في روعي أنّها تلدُ ذكراً، فخبّرتُه بذلك، فقال لي: إمضِ في حفظ الله، فلا سلّط الله عليك ولا على ذريتك ولا على أحدٍ من شيعتك شيئاً من السباع. فقلت: آمين»[502].
الخامسة: يعلم أنّ الله يراه فلا يعمل ما يغضبه، وأمّا إذا رأى أنّ الله لا يراه فهذا الكفر بعينه، فقد ورد عن إمامنا الصّادق× أنّه قال لإسحاق: «يا إسحاق، خفِ الله كأنّك تراه، وإن كنت لا تراه فإنّه يراك، فإن كنت ترى أنّه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنّه يراك ثُمَّ برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك»[503].
والحديث الذي صدّرنا به كلامنا يقول: لا بدّ أن يكون خوف الإنسان ورجاؤه ككفتي الميزان، لا أن يخاف الله تبارك وتعالى خوفاً يوصله إلى اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى، ويقع في القنوط واليأس من روحِ الله الذي عُدَّ من الكبائر، ولا يرجو الله تبارك وتعالى رجاءً يأخذ به إلى التجرّي بالمعصية على الباري.
فالمتّقون حقّاً مَن كانوا بين خوفٍ ورجاء؛ ولذا ترى كلام الأئمّةِ المعصومين^ في الأدعية وكأنّهم قد ارتكبوا معاصي الخلق أجمعين، وهم معصومون، ولكنّ هذا كلّه خوفٌ من الله تبارك وتعالى؛ لعلمهم بالله وعظمته ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾[504].
بلى والله هم العلماء ولكنَّ القوم ما عرفوا حقّهم ولا قدرهم.
وإلّا ما الذي صنعه أهل البيت^ بحيث أصبحوا أُسارى وسبايا من بلدٍ إلى بلدٍ، والدم يجري من ساقَي الإمام زين العابدين× من شدّة ما لاقاه من مصائب ومحن.
يقول المنهال بن عمر: كنتُ أتمشّى في أسواق دمشق وإذا أنا بعليِّ بن الحسين× يمشي ويتوكأ على عصاةٍ في يده، ورجلاه كأنهما قصبتان، والدم يجري من ساقيه والصُفرةُ قد علت عليه.
قال المنهال: فخنقتني العبرةُ، فاعترضتُه وقلتُ له: كيف أصبحتَ يا بن رسول الله؟ قال×: «يا منهال، وكيف يُصبح مَن كان أسيراً ليزيد بن معاوية، يا منهال، والله مُنذ قُتل أبي، نساؤنا ما شبعن بطونهن، ولا كسونَ رؤوسهنَّ، صائمات النهار، نائحات الليل»[505].
لهذا رُوي عن الإمام زين العابدين× أنّه قال: «دخلتُ على عمّتي زينب في طريقنا إلى الشام فرأيتُها تُصلي من جُلوس، فسألتها عن ذلك فقالت: أصلّي من جلوس لشدّة الجُوع والضعف. لأنّها منذ ثلاثة أيام لم يدخل في جوفها طعام، لأنَّها كانت تقسّمُ ما يُصيبُها من الطعام على الأطفال».
ولسان حال الإمام×:
|
يا عمّـه أشـوفنـچ تصـلّين |
فأجابته بلسان الحال:
|
يا عمّـه راح الحيـل مـنّي |
ثُمَّ قال له: «يا منهال، أصبحنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم، أصبحت العربُ تفتخرُ على العجم بأنَّ محمداً منهم، وتفتخرُ قريش على العربِ بأنَّ محمداً منهم، وإنَّا عترةُ محمّدٍ أصبحنا مقتولين مذبوحين مأسورين مشرّدين شاسعين عن الأمصار كأنّنا أولاد ترك أو كابل، هذا صباحنا أهل البيت. يا منهال، المكان الذي نحن فيه ليس له سقف، والشمس تصهرنا، فأفرَّ منه سُويعة لضعف بدني، وأرجع على عماتي وأخواتي خشيةً على النساء.
قال المنهال: فبينما أنا أخاطبه وهو يخاطبني، وإذا أنا بامرأة قد خرجت من الخربة وهي تناديه: إلى أين تمضي يا قرّة عيني، فتركني ورجع إليها، فحققّتُ النظر إليها وإذا هي زينبُ بنتُ عليٍّ»[506].
(أبوذية)
|
انزرع بالعين شوچ السهر وانبـات |
***
|
بناتُ زيادٍ في القصورِ مصونةٌ |
المحاضرة الثامنة والعشرون: كبائر الذنوب وصغائرها
|
أبا صالحٍ يا مُدركَ الثأرِ كمْ ترى وغيضُك وارٍ غَيرَ أنّكَ كاظِمُه |
***
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾[508].
لا ريب في دلالة الآية على انقسام المعاصي إلى كبائر، وصغائر وهي التي عبّرت عنها الآية المباركة (بالسيئات).
ونظير هذه الآية في الدلالة الآية الأُخرى التي يقول فيها سبحانه وتعالى على لسان المجرمين: ﴿يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ﴾[509]؛ إذ اشفاقهم ممّا في الكتاب يدلّ على أنّ المراد بالصغيرة والكبيرة صغائر الذنوب وكبائرها.
ولا ريب أيضاً في أن الآية في مقام الامتنان، وهي تقرع أسماع المؤمنين بعنايةٍ لطيفة إلهية أنّهم إنْ اجتنبوا البعض من المعاصي كفّر عنهم البعض الآخر.
فليس في ذلك إغراء على ارتكاب المعاصي الصغار، فإنّ ذلك لا معنى له؛ لأنّ الآية تدعو إلى ترك الكبائر بلا شك، وارتكاب الصغيرة من جهة أنّها صغيرة لا يعبأ بها ويتهاون في أمرها، يعود مصداقاً من مصاديق الطغيان والاستهانة بأمر الله سبحانه، وهذا من أكبر الكبائر، بل الآية تعدّ تكفير السيئات من جهة أنّها سيئات، لا يخلو الإنسان المخلوق على الضعف المبني على الجهالة من ارتكابها بغلبة الجهل والهوى عليه، فمساق هذه الآية مساق الآية الداعية إلى التوبة التي تعد غفران الذنوب، كقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾[510].
فكما لا يصح أن يقال هناك: إنّ الآية تغري بالمعصية بفتح باب التوبة، وتطيِّب النفوس بذلك، فكذا ههنا، بل أمثال هذه الخطابات إحياء للقلوب الآيسة بالرجاء.
ومن هنا يعلم أنّ الآية لا تمنع عن معرفة الكبائر بمعنى أن يكون المراد بها اتّقاء جميع المعاصي مخافة الوقوع في الكبائر، والإبتلاء بارتكابها، فإنّ ذلك معنى بعيد عن مساق الآية، بل المستفاد من الآية أنّ المخاطبين هم يعرفون الكبائر ويميّزون تلك الموبقات من النهي المتعلّق بها، ولا أقل من أن يُقال: إنّ الآية تدعو إلى معرفة الكبائر حتّى يهتمّ المكلّفون في الاتّقاء منها كلّ الاهتمام، من غير تهاون في تجنّب غيرها، فإنّ ذلك التهاون ـ كما عرفت ـ إحدى الكبائر الموبقة.
وذلك أنّ الإنسان إذا عرف الكبائر وميَّزها وشخّصها، عرف أنّها حرمات لا يغمض من هتكها بالتكفير إلّا عن ندامةٍ قاطعةٍ وتوبةٍ نصوحٍ، ونفسُ هذا العلم ممّا يوجب تنبّه الإنسان وانصرافه عن ارتكابها[511]. وعليه فلا بدّ أن نحدد ضابطاً لمعرفة كبائر الذنوب من صغائرها.
يذهب البعض إلى أن وصف الكبيرة والصغيرة من الأُمور النسبيّة، تكون كلّ معصية بالنسبة إلى ما هو أكبر منها صغيرة، وبالنسبة إلى ما هو أصغر منها كبيرة[512].
ولكن من الواضح أنّ هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر الآية الحاضرة؛ لأنَّها تقسّم الذنوب إلى صنفين مستقلّين، وتعتبرهما نوعين متقابلين، وتعتبر الاجتناب عن صنف موجباً للعفو والتكفير عن الصنف الآخر.
ولكنّنا إذا راجعنا المعنى اللغوي للكبيرة وجدنا أنّ الكبيرة هي كلُّ معصية بالغة الأهمّية من وجهة نظر الإسلام، ويمكن أن تكون علامة تلك الأهمية أنَّ القرآن لم يكتفِ بالنهي عنها فقط، بل أردف ذلك بالتهديد بعذاب جهنم، مثل قتل النفس والزنا ـ نستجير بالله ـ وأكل الربا وأمثال ذلك، ولهذا جاء في روايات أهل البيت^: «الكبائر التي أوجب الله عليها النار»[513].
وعلى هذا الأساس تسهل معرفة المعاصي الكبيرة إذا أخذنا بنظر الاعتبار الضابطة المذكورة، وما قد ذكر في بعض الروايات من أنّ عدد الكبائر سبع وفي بعض عشرون، وفي بعضها سبعون، لا ينافي ما ذكرنا قبل قليل؛ إذ إنّ بعض هذه الروايات يشير ـ في الحقيقة ـ إلى المعاصي الكبيرة من الدرجة الأُولى، وبعضها الآخر يشير إلى المعاصي الكبيرة من الدرجة الثانية، وبعضها الثالث يشير إلى جميع الذنوب الكبيرة.
إلّا أنّ هاهنا نقطة مهمّة لا بدّ من الالتفات إليها، وهي أنّ المعاصي الصغيرة تبقى صغيرة ما لم تتكرّر، مضافاً إلى كونها لا تصدر عن استكبار أوغرور وطغيان؛ لأنّ الصغائر ـ كما يستفاد من الكتاب العزيز والأحاديث الشريفة ـ تتبدّل إلى الكبيرة في عدّة موارد منها:
الأوّل: إذا تكرّرت الصغيرة قال الإمام الصّادق×: «لا صغيرة مع الإصرار»[514].
الثاني: إذا ستصغر صاحب المعصية معصيته واستحقرها، فقد جاء في نهج البلاغة «أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه»[515].
الثالث: إذا ارتكبها مرتكبها عن عِناد واستكبار وطغيان وتمرُّد على أوامر الله تعالى، وهذا هو ما يستفاد من آيات قُرآنية متنوّعة إجمالاً، مثل قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾[516].
الرابع: إن صدرت المعصية ممَّن لهم مكانة اجتماعية خاصّة بين الناس، وممَّن لا تحسب معصيتهم كمعصية الآخرين، فقد جاء في القرآن الكريم حول نساء النبي’ في سورة الأحزاب: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾[517].
الخامس: أن يفرح مرتكب المعصية بما اقترفه من المعصية، ويفتخر بذلك، كما رُويَ عن رسول الله’ أنّه قال: «مَن أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باكٍ»[518].
السادس: أن يعتبر تأخير العذاب العاجل عنه على المعصية دليلاً على رضاه تعالى، ويرى العبد نفسه محصّناً من العقوبة آمناً من العذاب، أو يرى لنفسه مكانةً عند الله لا يعاقبه الله على معصية لأجلها، كما جاء في سورة المجادلة، الآية الثامنة حاكياً عن لسان بعض العصاة المغرورين الذين يقولون في أنفسهم ﴿لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ ثُمَّ يردُّ عليهم القرآن الكريم قائلاً: ﴿حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ﴾[519].
ثمَّ إنَّ هذه الآية ليست عديمة النظير من الآيات القرآنية الأُخرى؛ فإنّ لفظ السيئات ورد بألفاظ متّحدة معها في المعنى متغايرة بلفظها، كما ورد في بعض الآيات التعبير بـ(اللّمم)، كما في الآية الثانية والثلاثين من سورة النجم، بدلاً عن التعبير بالسيئة قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾.
إذن، هذا البحث يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنَّ الإنسان إذا تجنّب الكبائر وصدرت منه الصغائر ـ لكن لا على نحو الإصرار والعناد والاستخفاف ـ كفّر الله عنه هذه الصغائر.
وأمّا إذا صدرت هذه الصغائر نفسها بشكل مستمر ودائم مع الإصرار والعناد فسوف تتحوّل هذه الصغائر إلى كبائر، بل إلى أكبر الكبائر فيكون مثلها كمثل بقية الكبائر مثل قتل النفس المحترمة، والإضرار بالمسلم ومَن بحكمه، في نفسه، أوماله، أوعرضه.
فما حال مَن تعرّض لجميع البلاءات بسبب كبائر العصاة وجناياتهم، فقد أضرَّ القوم بنفسه وبعياله وأطفاله، بين صغيرة لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات وهي رقية بنت الإمام الحسين وأُمُّها الرباب؛ إذ لدت رقية‘ أواخر السنة السابعة والخمسين للهجرة، وبعد أن أُخذت‘ مع الأسيرات من بيت النبوة إلى الشام استمرت في البكاء ليلها ونهارها؛ لفراق أبيها الإمام الحسين×، وكانوا يقولون لها: إنَّ أباك في السفر (يقصدون سفر الآخرة) فرأته ليلة في منامها، ولمّا استيقظت أخذت بالبكاء الشديد وهي تقول: ائتوني بوالدي وقرّة عيني.
وكلمّا أراد أهل البيت إسكاتها ازدادت حزناً وبكاءً، ولبكائها زاد وكثر حزن أهل البيت^، فأخذوا في البكاء الشديد، فسمع يزيد صيحتَهم وبكاءَهم، فقال: ما الخبر؟
قيل له: إنّ بنتَ الحسين الصغيرة الموجودة مع السبايا في الخربة رأت أباها في نومها، فاستيقظت وهي تطلبه وتبكي وتصيح، فلمّا سمع يزيد ذلك قال: ارفعوا إليها رأس أبيها وضعوه بين يديها تتسلّى به، فأتوا بالرأس الشريف في طبق مغطى بمنديل، ووضعوه بين يديها، فقالت: ما هذا؟ إني أطلبُ أبي، ولم أطلُب الطعام، فقالوا: هذا أبوك، فرفعت المنديل فرأت رأساً، فقالت: ما هذا الرأس؟ قالوا: رأس أبيك، فرفعت الرأس وضمته إلى صدرها، وهي تقول: يا ابتاه من الذي أيتمني على صغر سني؟ يا أبتاه، من للعيون الباكيات؟ يا أبتاه مَن للضائعات الغريبات؟ يا أبتاه من بعدك وا خيبتاه، من بعدك وا غربتاه، يا أبتاه ليتني كنت لك الفداء، يا أبتاه ليتني كنت قبل هذا اليوم عمياء، يا أبتاه ليتني توسَّدت التراب ولم أرَ شيبك مخضّباً بالدماء، ثُمَّ وضعت فمها على فم أبيها الشهيد المظلوم وبكت حتّى غشي عليها!!
قال الإمام زين العابدين×: «عمّه زينب، ارفعي اليتيمة من على رأس والدي فإنّها فارقت الحياة»[520].
|
يا عمّه زينب گومي ليها |
فلمّا حرّكتها زينب وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا فارتفعت الأصوات وعلا الصُراخ.
(فائزي)
عمتها من گامت اوشالتها بديها
من راس أبوها اوعاينت ويلي عليها
لنها اليتيمة امغمضة اولا نفس بيها
صاحت يعمّه امصيبتچ زادت إبچانه
گامن فرد گومه الحرم كلهن سويه
هاي التحبها وذيچه اتشمها رقيه
قيل: وأحضر لها أهلُ البيت مغسّلةً لتغسلها، فلمّا جرّدتها عن ثيابها قالت: لا أغسّلُها، فقالت لها زينب‘: ولِمَ لا تغسليها؟ قالت: أخشى أن يكون فيها مرض، فأنّي أرى أضلاعها زرقاً، قالت زينب: والله، ليس فيها مرض ولكنّ هذا من ضرب سياط أهلِ الكوفة.
|
من جلّة الوالي علينه |
اويشـــتمون حامـينه اووليـــنه[521]
***
|
لا أضحك الله سنَّ الدهرِ إنْ ضَحكتْ |
المحاضرة التاسعة والعشرون: الرسالة السماوية
|
يـا بـَن الـنـبـيِّ لـنـا بـبـابـِكَ
وقـفـةٌ |
***
|
المثلك عدل ما مات يحسين |
والآن هلمّوا معي ننظر ماذا يجري علی الرأس الشريف:
|
من يصد لعياله يساره |
اسمعوا جواب العقيلة‘:
(بحراني)
صـبـر ولـوكـلـفـه اوصعبه هالرزيه
أصـبـر ولا خَلِّـي الـعـده ايـشـمتون بيه
بس امن أصد الراسك اعلی السمهريه
ذاك الـوكـت ما أگـدر أحبـس دمعة العين
يـحـسـيـن راسـك مـن يـشيلونه اگبالي
ما يمكن أصبر من أصدّ له علی العوالي
سـامـحـني لوناديت يا ابن أُمّي الغالي
ولو سال دم راسي وخمشت أخدودي الاثنين
***
قال تعالی: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[523].
النبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده، لتدبير حياتهم في أمر معاشهم، والنبيّ هو الإنسان المخبِر عن الله تعالی بإحدی الطرق المعروفة[524].
إذا عرفنا معنی النبوة والنبيّ تعال معي لنعرف ما هي الطرق التي تعرفنا بصدق دعوی النبوة؟ إذ من الممكن لأي إنسان أن يدَّعي النبوة والسفارة الإلهية بين الله تبارك وتعالی وبين ذوي العقول، كما ذكرنا في تعريف النبوة!
فمن هنا ـ إذن ـ يجب أن تقترن دعوی النبوة بدليلٍ يثبت صحّتها، وإلّا كانت دعوی غير قابلة للإذعان والقبول، وهذا طبيعي جدّاً وتقتضيه الفطرة الإنسانية.
هناك طرق ثلاث للوقوف علی صدق مدَّعي النبوة في دعواه، وهي:
1 ـ الإعجاز.
2 ـ تصديق النبيّ السابق نبوة النبيّ اللاحق.
3 ـ جمع القرائن والشواهد من حالات المدّعي وتلامذة منهجه[525].
ولذا نری أنَّ الآية المباركة ابتدأت أوّلاً بذكر البيّنات والدلائل الواضحات الشامل للمعجزات والدلائل العقلية التي يتسلّح بها الأنبياء والرسل الإلهيون[526].
والمعجزة: «أمر خارق للعادة مقرونٌ بالتحدّي مع عدم المعارضة»[527].
إذ إنَّ هُناك أُموراً تُعدّ خارقة (مضادة) للعقل، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما، ووجود المعلول بلا علّةٍٍ ونحو ذلك مع أنّها ليست كذلك في واقع الأمر، بل هي ممّا يخالف القواعد العاديّة، بمعنی أنـّها تُعدّ محالات بحسب الأدوات والأجهزة العادية، وهي المُسماة بالمعاجز، وذلك كحركة جسمٍ كبير من مكان إلی مكانٍ آخر بعيد عنه في فترةٍ زمانية لا تزيد علی طرفة العين بلا تلك الوسائط العاديّة فإنّ ذلك غير ممتنع عقلاً ولكنّهُ محال عادةً.
ومن هذا القبيل مايحكيه القُرآن من قيام مَن أوتي علماً من الكتاب[528] بإحضار عرش بلقيس ـ ملكة سبأ ـ من بلاد اليمن إلی بلاد الشام في طرفة عين، بلا توسّط شيءٍ من تلك الأجهزة المادّية المتعارفة.
إذن، الإعجاز أمرٌ خارق للعادة لا للعقل، فإذا جاء إنسانٌ بما هو خارق للعادة لا يسمّی نبياً إلّا إذا كان مقترناً بدعوی النبوة، وأمّا إذا تجرّد عنها وصدر من بعض أولياء الله تعالی يسمّی حينئذٍ (كرامة).
ومع هذا حتّی ولو تمَّ الأمران وهما: إتيان المعجزة مع التحدّي ودعوی النبوة إذا لم يكن معهما أمرٌ ثالث ـ وهو عدم تمكن باقي الناس من الإتيان بمعارضة ما أتی به مدَّعي النبوة ـ لم يكن المدَّعي نبيّاً حينئذٍ.
ومن شرائط كون الإعجاز دليلاً علی صدق دعوی النبوة أن يكون فعل المدَّعي مطابقاً لدعواه، فلو خالف ما ادّعاه لما سُمّي مُعجزة، وإن كان أمراً خارقاً للعادة، ومن ذلك ما حصل من مسيلمة الكذّاب عندما ادّعی أنّه نبيّ، وادّعى أنّ آية نبوته أنّه إذا تفل في بئر ٍ قليلة الماء يكثر ماؤها، فتفل فغار جميعُ مائها[529].
الطريق الأول: معاجز النبيّ الأكرم
بعدما عرفنا معنی الإعجاز والمعجزة، وأنّها من الطرق الثلاث الدالّة علی صدق دعوی النبوة، تعال معي الآن لنتعرف علی قطرةٍ من معاجز النبيّ الأكرم’، وهي كثيرة دالة علی نبوته سوی القرآن الكريم.
منها: مجيء الشجرة إليه، ذكرها أميرالمؤمنين× في خطبته القاصعة قال: «لقد كنتُ معه’ لمّا أتاه الملأُ من قريش فقالوا له: يا محمّد، إنّك قد ادّعيت عظيماً لم يدَّعه آباؤك ولا أحد من بيتك، ونحنُ نسألك أمراً إن أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نبيٌّ ورسولٌ، وإن لم تفعل علمنا أنّك ساحرٌ كذّاب.
فقال لهم: وماتسألون ؟
قالوا: تدعو لنا هذهِ الشجرة حتّی تنقلع بعروقها وتقف بين يديك.
فقال’: إنَّ الله علی كلِّ شيءٍ قدير، فإن فعل ذلك بكم أتؤمنون وتشهدون بالحقّ؟!
قالوا: نعم.
قال: فإنّي سأريكم ما تطلبون، وإنّي لأعلم أنّكم لا تفيئون إلی خير ٍ، وإنَّ فيكم مَن يُطرح في القليب[530]، ويُحزّب الأحزاب، ثُمَّ قال: أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أنّي رسولُ الله فانقلعي بعروقك حتّی تقفي بين يديّ بإذن الله.
فوَ الذي بعثه بالحقّ، لانقلعت بعروقها، وجاءت ولها دوي شديد وقصفٍ كقصفِ أجنحة الطير، حتّی وقفت بين يدي رسول الله’ مرفرفة، وألقت بغصنها الأعلی علی رأس رسول ِ الله، وببعض أغصانها علی منكبي، وكنتُ علی يمينه’.
فلمّا نظر القوم إلی ذلك قالوا علّواً واستكباراً: فمرها فليأتك نصفها ويبقی نصفها. فأمرها بذلك، فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبالٍ وأشدّه دويّاً وكادت تلتفُّ برسول ِ الله.
فقالوا كفراً وعتوّاً: فمر هذا النصف فليرجع إلی نصفه، فأمره’ فرجع.
فقلتُ أنا: لا إله إلّا الله، إنـّي أول مؤمنٍ بك يا رسولَ الله، وأوّل مَن آمن بأنَّ الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تصديقاً لنبوتك وإجلالاً لكلمتك.
فقال القوم: بل ساحرٌ كذّاب، عجيبُ السحر، خفيفٌ فيه، وهل يُصدّقُك في أمرك غير هذا؟! يعنوني»[531].
ومنها: خروج الماء من بين أصابعه، وذلك أنّهم كانوا معه في سفرٍ فشكوا أن لا ماء معهم وأنّهم بعرض التلف وسبيل العطب، فقال: «كلّا، إنّ معيَ ربّي عليه توكلتُ»، ثُمَّ دعا بركوةٍ فصبّ فيها ماء ما كان ليروي رجُلاً ضعيفاً، وجعل يده فيها فنبع الماء من بين أصابعه، وصيح في الناس، فشربوا وسقوا حتّی نهلوا وعلـّوا وهم ألوفٌ، وهويقول: «أشهدُ أنّي رسولُ الله حقّاً».
ومنها: حنين الجذع الذي كان يخطب عنده’.
ومنها: كلام الذراع المسمومة التي أهدتها له امرأة من اليهود بخيبر.
ومنها: انشقاق القمر له نصفين بمكة في أول بعثته’.
هذا غيضٌ من فيض ٍوقطرة من بحار معاجز النبي’، وهوأكثر الأنبياء معاجز وكرامات، وقد ذكر بعض المصنّفين: أنَّ معاجزه تبلغ ألفاً، فالأولی الاقتصار علی الاختصار[532].
الطريق الثاني: تنصيص النبيّ السابق
إذا ثبتَ نبوة نبيّ بدلائل مفيدة للعلم بنبوته، ثُمَّ نصّ هذا النبيّ علی نبوة نبيٍّ لاحق يأتي من بعده، كان ذلك حجّة قطعية علی نبوة اللّاحق، لا تقل في دلالتها عن المُعجزة؛ وذلك لأنَّ النبيَّ الأول، إذا ثبتت نبوته يثبت كونه معصوماً عن الخطأ والزلل لا يكذب ولا يسهو، فإذا قال ـ والحالُ هذه ـ سيأتي بعدي نبيّ اسمُه كذا، وأوصافه كذا وكذا، ثُمَّ ادّعی النبوّة بعده شخصٌ يحمل عين تلك الأوصاف والسمات، يحصل القطع بنبوته.
ومن هذا الباب تنصيص المسيح عيسى بن مريم× علی نبّوة النبيّ الخاتم’، كما يحكيه سُبحانه بقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ﴾[533].
ويظهر من الذكر الحكيم أنَّ السلف من الأنبياء وصفوا النبيَّ الأكرم بشكلٍ واضح، وأنَّ أهل الكتاب كانوا يعرفون النبيّ كمعرفتهم لأبنائهم، قال سُبحانه: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[534].
بناءً علی رجوع الضمير إلی النبيّ المعلوم من القرائن، لا إلی الكتاب.
وقال سُبحانه: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[535].
وقد آمن كثيرٌ من اليهود والنصاری بنبوة النبيّ الخاتم في حياته وبعد مماته لصراحة التباشير الواردة في العهدين.
هذا وإنَّ الاعتماد علی هذا الطريق في مجال نبوة النبيّ الخاتم في عصرنا هذا يتوقّف علی جمع البشائر الواردة في العهدين وضمّها إلی بعضها، حتّی يخرج الإنسان بنتيجة قطعية علی أنَّ المُراد من النبيّ المبشَّر به فيها هو النبيّ الخاتم، وقد قام بهذا المجهود لفيفٌ من العُلماء وألّفوا فيه كُتباً[536]منها: «كتاب أنيس الأعلام، ومؤلفه كان قسّيساً مُحيطاً بالعهدين وغيرهما، وقد تشرّف بالإسلام، وألف كـُتباً كثيرة منها هذا الكتاب، وقد طـُبع في ستّة أجزاء»[537].
الطريق الثالث: جمع القرائن والشواهد
هذا هو الطريق الثالث لتمييز النبيّ الصّادق عن المتنبي الكاذب، وهذا الطريق ضابطة مطَّردَة في المحاكم القانونية، معتمدٌ عليه في حلّ الدعاوی والنزاعات، يسلـُكه القضاة في إصدار أحكامهم، ويستند إليه المحامون في إبراء موكّلهم، وتقضي هذهِ الطريقة بجمع كلّ القرائن والشواهد التي يُمكن أن تؤيد دعوی المدّعي، أوإنكار المُنكر، وضمّها إلی بعضها حتّی يحصل القطع بصحّة دعواه أو إنكاره.
ويمكن تطبيق هذه الطريقة بعينها في مورد دعوی النبيّ للنبوة، فنتحرّی جملة القرائن التي يُمكن أن نقطع معها بصدق الدعوی.
وأوّل مَن طرق هذا الباب وجعل القرائن المفيدة للقطع بصدق المدّعي دليلاً علی صحّة الدعوی، هو قيصر الروم، فإنـَّه عندما كتب إليه النبيّ الأكرم’ رسالةً يدعوه فيها إلی اعتناق دينه الذي أتی به، أخذ ـ بعد استلامه الرسالة ـ يتأمّل في عبارات الرسول، وكيفيّة الكتابة، حتّی وقع في نفسه احتمال صدق الدعوی، فأمر جماعةً من حاشيته بالتجوّل في الشام والبحث عمَّن يعرف الرسول عن قـُرب، ومطَّلعٌ علی أخلاقه وروحياته، فانتهی البحث إلی العثور علی أبي سُفيان وعدّة كانوا معه في تجارة إلی الشام، فأحضروه إلی مجلس قيصر، فطرح عليهم الأسئلة التالية:
كيف نسبه فيكم؟
قال أبوسفيان: محضٌ، أوسطنا نسباً.
أخبرني، هل كان أحدٌ من أهل بيته يقول مثلما يقول، فهو يتشبّهُ به؟
قال أبو سفيان: لا، لم يكن في آبائه مَن يدّعي ما يقول.
قال قيصر: هل كان له فيكم مُلكٌ فاستلبتموه إيّاه، فجاء بهذا الحديث لتردّوا عليه ملكه؟
أبو سُفيان: لا.
قيصر: أخبرني عن أتباعه منكم مَن هم؟
أبوسفيان: الضُعفاء والمساكين والأحداث من الغـُلمان والنساء، وأّمّا ذوو الأسنان والشرف فلم يتبعه منهم أحدٌ.
قيصر: أخبرني عمَّن تبعه، أيُحبّه ويُلازمه؟ أم يَقليه ويفارقـُه؟
أبو سُفيان: ما تبعه رجلٌ ففارقه.
قيصر: أخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟
أبو سُفيان: سجال، يُدال علينا وندال عليه.
قيصر: أخبرني هل يغدر؟
أبو سفيان: (لم أجد شيئاً ممّا سألني عنه أغمزه فيه غيرها) فقُلتُ: لا ونحن منه في هدنة، ولا نأمنُ غدره. (وأضاف أبو سُفيان بأنَّ قيصر ما التفت إلی الجملة الأخيرة منه).
قال قيصر ـ بعد هذهِ الأسئلة العديدة ـ: سألتكَ كيف نسبه فيكم، فزعمت أنّه محضٌ، من أوسطكم نسباً، وكذلك يأخذ الله النبيّ إذا أخذه لا يأخذه إلّا من أوسطِ قومه نسباً، وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبّه به، فزعمت أن لا. وسألتك هل كان له فيكم مُلك فاستلبتموه إيّاه، فجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه، فزعمت أن لا. وسألتك عن أتباعه فزعمت أنّهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء، وكذلك أتباع الأنبياء في كلّ زمان. وسألتك عَمّن يتبعه، أيُحبُّه ويلزمه، أم يَقليه ويُفارقـُه؟ فزعمت أن لا يتبعه أحد فيفارقه، وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخلُ قلباً فتخرج منه، وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أن لا. فلئن صدقتني عنه ليغلبني علی ما تحت قدميَّ هاتين، ولوددتُ أنّي عنده فأغسل قدميه، انطلق لشأنك.
قال أبوسفيان: «فقمتُ من عنده وأنا أضربُ إحدی يديّ بالأُخری وأقول: أي عباد الله، لقد أمِرَ أمرُ ابن أبي كبشة، أصبح ملوك بني الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشام»[538].
فإذن، ملكات النبيّ النفسية، ومضمون دعوته، والأدوات التي يستفيد منها في دعوته، والمؤمنون به،كـُلّها شواهد علی صدق دعواه’.
هذا ثُمَّ نرجع إلی الآية حيث قالت: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ أرسَل الله تبارك وتعالی الرُسُل ـ بما فيهم النبيّ الخاتم’ ـ ومعهم الحجج القاطعة التي يتبّين بها أنـَّهم مرسلون من جانب الله سُبحانه وتعالی، وأنزل معهم الكتاب، وهو الوحي المشتمل علی معارف الدين من اعتقاد وعمل، والكتب خمسة: كتاب نوح، وكتاب إبراهيم، والتوارة، والإنجيل، والقـُرآن.
والميزان يعني الدين، فهو الذي يوزن به الأعمال والعقائد، وهذا المعنی هوالملائم لحال الناس من حيث خشوعهم وقسوة قلوبهم[539]؛ ولذا تری أنَّ مَن قسا قلـُبه ولم تنزل فيه رحمة الله تبارك وتعالی ينكر النبوة والوحي، وينكر الدين. وإلّا كيف تُفسّر موقف يزيد عندما جاؤوه برأس الحسين× وسبايا بيت الرسالة؟!
يقف يزيد (عليه لعائن الله) فيتجاسر علی رأس سيد الشهداء مُظهراً كُفـره بقوله:
|
ليت أشياخي ببدر ٍ شهدوا |
فقامت إليه ابنةُ أمير المؤمنين÷ وهي تحمل قلب عليّ؛ لتقول: «الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلی الله علی رسوله وآله أجمعين، صدق الله سُبحانه حيث يقول: ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴾[541] أظننتَ يايزيدُ حيثُ أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نـُساق كما تُساق الإماء أن بـِنا علی الله هواناً وبك عليه كرامة، فشمختَ بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسروراً حين رأيت الدُنيا لك مستوسقة والأُمور متّسقة، وحين صفا لك مُلكـُنا وسُلطاننا، فمهلاً مهلاً أنسيت قول الله تعالی: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾[542].
أمن العدل يا بن الطُـلقاء تخديرُك حرائرك وإماءَك وسَوْقك بناتِ رسولِ الله سبايا؟! قد هتكت ستورهنَّ وأبديتَ وجُوههنَّ، تحدو بـِهنَّ الأعداء من بلدٍ إلی بلدٍ...»[543].
|
فمن بلدةٍ تـُسبی إلی شرِّ بلدةٍ |
وكأنّي بالحوراء زينب‘ لمّا نظرت إلى رأس أخيها على رأس الرمح الطّويل:
|
لـمّـن شـافـتـه صـفـگـت بديها |
(عاشوري)
|
عـلـی الـجـثث مروا بالنساوين |
(نعي)
|
نـاده الـولي اوضـنوة الطّيبين |
(أبوذية)
|
زجر يحسين من عگبك محنـّه |
***
|
وشيبتـُه مخضوبة ٌ بدمائِه |
المحاضرة الثلاثون: علامات المؤمن
|
قم جَدّدِ الحُزنَ في العشـرينَ من صفرِ فـفـيـهِ رُدت رؤوسُ الآل للحُـفرِ |
وكأنّي بهن يخاطبْنَ أبا عبد الله الحسين×:
|
جينـه اوعله گبرك گعـدنه |
قيل: وأجالت زينب بطرفها يميناً وشمالاً فقيل لها: لعلك تريدين شيئاً؟ قالت: قوموا بنا إلى قبر أبي الفضلِ العبّاس.
|
صاحت يالحرم گومن امشنّه |
وأمّا الحوراء زينب×:
|
زينب تصب دمعات العيون |
***
روي عن إمامنا الحسن العسكري× أنّه قال: «علاماتُ المؤمنِ خمس: صلاةُ الخمسين، وزيارةُ الأربعين، والتختّمُ في اليمين، وتعفير الجبينِ، والجهرُ ببسمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ»[546].
شهر محرّم وصفر شهران لم يشهد المؤمن مثلهما على طول أيام السنة؛ لتجدد أحزان محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين فيهما، وإن كانت أحزانهم ومظلومياتُهم غير مختصّة بهذين الشهرين، ولكن لمصيبة سيد الشهداء× أبيِّ الضيم خصوصية، خصّه الله تبارك وتعالى بها؛ ولهذا ترى المعصومين^ من النبيّ الخاتم إلى الإمام الحجّة القائم^، عندما يتعرّضون لمصيبة سيد الشهداء× يجعلون لها الحظَّ الأوفَر، وليس معنى هذا سهولةُ مُصيبة باقي المعصومين^، بل المقصود عظم مصيبة أبي عبد الله×، وقد عبّر عن ذلك الإمام الرضا× حيث قال: «إنّ يومَ الحُسينِ أقرحَ جفونَنا، وأسبل دموعَنا، وأذَلَّ عزيزَنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكربَ والبلاءَ إلى يومِ الانقضاء...»[547].
وسوف لا نخوض في الحديث عن العلامات الأربع الأُولى التي جعلها الإمام× من صفات المؤمنين، فهي وإن كانت جديرة بالبحث والبيان إلّا أنَّ المناسبة تقتضي تسليط الضوء على العلامة الثانية، أعني، (زيارة الأربعين).
زيارة الأربعين في التاريخ غير الإسلامي
من النواميس المطّردة عند الناس هو الاعتناء بالفقيد بعد مضيّ أربعين يوماً من وفاته، بإسداء البِرِّ إليه وتأبينهِ، وعدّ مزاياه في جلسات تعقد، وذكريات تردد وتدوَّن؛ تخليداً لذكره، على حين أن الخواطر تكاد تنساه، والأفئدة أوشكت أن تهمله، فبذلك تعاد إلى ذكره الفائت صورة جديدة ترسمها ألسنُ المؤبّنين.
وقد ورد عن أبي ذرّ الغفاري وابن عباس (رضي الله عنهما) عن النبيّ الأكرم’ «إنَّ الأرضَ والسّماءَ لتبكي على المؤمنِ إذا ماتَ أربعينَ صباحاً»[548].
وعن زرارة عن أبي عبد الله×، قال: «يا زرارة، إنَّ السماء بكت على الحسين× أربعين صباحاً بالدم، وإنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد، وإنّ الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، وإنّ الجبال تقطّعت وانتثرت، وإنّ البحار تفجَّرت، وإنّ الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين×، وما اختضبت منّا امرأة ولا ادّهنت ولا اكتحلت ولا رجّلت حتّى أتانا رأس عبيد الله بن زياد، ومازلنا في عَبرةٍ من بعده»[549].
وكلّ هذا يؤيد ويؤكّد هذه الطريقة المألوفة، والعادة المستمرة بين الناس، من الحداد على الميّت أربعين يوماً، فإذا كان يوم الأربعين أُقيم على قبره العزاء بتأبينه، ويحضره أقاربه وخاصّته وأصدقاؤه، وهذه العادة لم تختصّ بالمسلمين، بل تشمل حتّى اليهودَ والنصارى؛ فإنَّ النصارى يقُيمون حفلةً تأبينية يوم الأربعين من وفاة فقيدهم يجتمعون في الكنيسة، ويعيدون الصلاة عليه المسماة عندهم بصلاة الجنازة، ويفعلون ذلك في نصف السنة، وعند تمامها.
وكذا اليهود يُعيدون الحداد على فقيدِهم بعدَ مرُور ثلاثين يَوماً، وبمرور تسعة أشهر، وعند تمام السنة[550].
وكلّ ذلك إعادة لذكراه وتنويهاً بآثاره وأعماله إن كان من العظماء مثلاً.
إذن، الفكرة لا تختصّ بفئة دون فئة ولا بطائفة دون أُخرى، ولا يمكن لأي إنسان منحه الله عقلاً سليماً، وفكراً صحيحاً أن يتعدّى سيّد الشُهداء× دون أن يُعطيه حقّه الذي منحه الله تبارك وتعالى له، فهو الأولى بكلّ ذلك من كلّ أحدٍ، وهو الجدير بأن تُقام لـه الذكريات في كلّ مكانٍ، وتُشدّ إليه الرحال للوقوف عند قبره المقدّس.
ولهذا اطّردتْ عادةُ الشيعة على تجديد العهد بتلكم الأحوال يوم الأربعين من كلّ سنة، ولعل رواية أبي جعفر الباقر×: «إنّ السماء بكت على الحُسين أربعين صباحاً تطلعُ حمراء وتغرب حمراء»[551]تلمح إلى هذه العادة المألوفة بين الناس.
هل تشمل زيارة الأربعين سائر المعصومين ^ أم لا؟
إنّ الأئمّة من آل الرسول’ وإن كانوا كلّهم أبواب نجاة، وسفن رحمة، وبولائهم يعرف المؤمن من غيره، وكلّهم استشهدوا على أيدي طواغيت عصرهم، فكان الواجب إقامة المأتم في يوم الأربعين من شهادة كلّ واحدٍ منهم، وحديث الإمام العسكري× لم يشتمل على قرينة لفظية تصرف هذه الجملة (زيارة الأربعين) إلى خصوص الحسين×، إلا أنّ القرينة الحالية أوجبت فهم العلماء الأعلام (قُدس سرّهم) من هذه الجملة خصوص زيارة الحسين×؛ لأنَّ قضية سيّد الشهداء× هي التي ميّزت بين دعوة الحقّ والباطل؛ ولذا قيل: الإسلام بدؤه محمدي وبقاؤه حسيني، وحديث الرسول’ «حسين مني وأنا من حسين»[552] يشير إليه.
ومن هنا لم يرد التحريض من الأئمّة على إقامة المأتم في يوم الأربعين من شهادة كلّ واحد منهم، حتّى نبيّ الأُمَّة’ مع إيماننا بأنّه الأعظم من الحسين×، ومن هنا فالذي يتجلّى للسامع هو اختصاص زيارة الأربعين بالحسين×، ويتجلّى أيضاً أنّها من صفات المؤمنين وليس لكلّ أحد أن يتّصف بها، وكذا العلامات الأُخر.
هل يمكن حمل زيارة الأربعين على زيارة أربعين مؤمناً؟
قد يشكل البعض، أو قد يأتي إلى ذهن أحد، أو يلتوي آخرون في أن المقصود من زيارة الأربعين هو زيارة أربعين مؤمناً، فيكون معنى الحديث: إنّ من علامات المؤمن صلاة الخمسين وزيارة أربعين مؤمناً.
وهذا فهم يأباه الفهم السليم لسياق الحديث وقرائنه، مع أنّه عَارٍ عن أي قرينة، ولو كان الفرض هو الإرشاد إلى زيارة أربعين مؤمناً لقال× «وزيارة أربعين» «أو زيارة أربعين مؤمناً»، فالاكتفاء بالجملة من غير ذلك، والإتيان بالألف واللام العهدية، كلّ ذلك يبعد الحمل الموهوم ويُقرّب المطلوب.
أضف إلى ذلك كلّه أنّ زيارة أربعين مؤمناً ليست من مختصّات المؤمنين وعلاماتهم التي يعرفون بها، بل هي من علائم الإسلام والمسلمين.
نعم زيارة الحسين× يوم الأربعين مِن قتله ممّا يدعو إليه الإيمان الخالص بأهل البيت^، وقد وردت زيارة الحسين× يوم الأربعين عن صفوان الجمّال عن الإمام الصّادق× ولم ترد زيارة الأربعين لباقي المعصومين^، ممّا يؤكّد اختصاص أربعين الحسين× بميزة خاصّة. ومعلوم أنَّ الذين يحضرون في الحائر الحسيني الأطهر ـ بعد مرور أربعين يوماً من مقتل سيد الشهداء سيد شباب أهل الجنّة ـ خصوص المتابعين له السائرين على أثره[553].
كلام الفقهاء الأعلام وفهمهم للحديث
إنّ فهم الفقهاء الأعلام وكلماتهم في المراد من زيارة الأربعين هو الفصل في هذا المقام. منهم أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي+ في التهذيب[554]، فإنّه بعد أن روى الأحاديث في فضل زيارته المطلقة ذكر منها المقيّد بأوقاتٍ خاصّة، ومنها يوم عاشوراء، وبعده روى هذا الحديث، وهذا دليل واضحٌ وصالح على ما أردناه من أنَّ المقصود من زيارة الأربعين زيارة أربعين الإمام الحسين×، وإلّا لما ذكره هناك ولَذَكَرَه في باب التزاور بين المؤمنين واستحباب عيادة المريض ـ مثلاً ـ إلى غير ذلك من الأبواب التي هي الأنسب من غيرها جزماً.
وفي مصباح المتهجد ذكر شهر صفر وما فيه من الحوادث، ثُمَّ قال: وفي يوم العشرين منه رجوع حرم أبي عبد الله× من الشام إلى المدينة ـ مدينة رسول الله’ ـ وورود جابر بن عبد الله الأنصاري إلى كربلاء لزيارة أبي عبد الله’ فكان أول مَن زاره من الناس، وهي زيارة الأربعين. فرويَ عن أبي محمّد الحسن العسكري× أنّه قال: «علامات المؤمن خمس...»[555].
وقال العلّامة الحلّي في المنتهى، كتاب الزيارات بعد الحجّ: يُستحب زيارة الحسين× في العشرين من صفر، ثُمَّ ساق الحديث نفسه[556].
وفي الإقبال للسيد بن طاووس عند ذكر زيارة الحسين× في العشرين من صفر، وساق الحديث المذكور أيضاً[557].
ونقل العلّامة المجلسي (أعلى الله مقامه الشريف)، في مزار البحار هذا الحديث عند ذكر فضل زيارة الحسين× يوم الأربعين[558].
وفي الحدائق للشيخ يوسف البحراني في الزيارات بعد الحجّ قال: وزيارة الحسين في العشرين من صفر من علامات المؤمن[559].
وحكى الشيخ الجليل المحدِّث عبّاس القمي في المفاتيح هذه الرواية عن التهذيب ومصباح المتهجّد في الدليل على رجحان الزيارة في الأربعين من دون تعقيب باحتمال إرادة أربعين مؤمناً [560].
وكذا نصَّ على الاستحباب الشيخ المفيد في كتابه (مسارّ الشيعة)[561]، والعلّامة الحلّي في التذكرة[562] والتحرير[563]، وملّا محسن الفيض الكاشاني في تقويم المحسنين[564].
وفي ذكر هؤلاء الأعلام ممَّن هم أهل الدراية والرواية من أمثال شيخ الطائفة الطوسي& ما فيه غنىً وكفاية.
زيارة جابر & لكربلاء
ولنذكر هنا رواية مجيء جابر بن عبد الله الأنصاري إلى كربلاء.
يقول عطية بن سعد بن جنادة العوفي: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري& زائرين قبر الحسين×، فلمّا وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل، ثُمَّ ائتزر بإزار، وارتدى بآخر، ثُمَّ فتح صرّة فيها سُعد، فنثرها على بدنه، ثُمَّ لم يخطُ خطوةً إلّا ذكر الله، حتّى إذا دنا من القبر قال: ألمسنيه ـ أي خذ بيدي إلى القبر؛ إذ أنّ جابراً قد فقد بصره آنذاك ـ فألمسته فخرَّ على القبر مغشيَّاً عليه، فرششت عليه شيئاً من الماء، فأفاق وقال: يا حسين. ثلاثاً، ثُمَّ قال: حبيبٌ لا يجيب حبيبه. ثُمَّ قال: وأنّى لك بالجواب، وقد شحطت أوداجُك على أثباجك، وفُرّق بين بدنك ورأسك... ثُمَّ جال ببصره حول القبر، وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلّت بفناء الحسين×، وأناخت برحله.. إلى أن قال: لقد شاركناكم فيما دختلم فيه.
قال عطية: فقلتُ لجابر: وكيف ولم نهبط وادياً، ولم نعلُ جبلاً، ولم نضرب بسيف، والقوم قد فُرِّقَ بين رؤوسهم وأبدانهم، وأُيتمت أولادهم، وأُرملت الأزواج؟
فقال لي: يا عطيّة، سمعتُ حبيبي رسولَ الله’ يقول: «مَن أحبّ عمل قومٍ اُشرك في عملهم..»
والذي بعث محمداً بالحقّ نبيّاً إنّ نيتي ونيّة أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه.
قال الراوي: فلمّا صرنا في بعض الطريق فقال لي: يا عطية، هل أوصيك؟ وما أظنّ إنّني بعد هذه السفرة ملاقيك، أحِبَّ محُبَّ آلِ محمّدٍ ما أحَبَّهُم، وأبغِض مُبغِضَ آل مُحمّدٍ ما أبغَضَهُم، وإن كان صوّامَاً قوّاماً، وارفق بمُحِبِّ آل محمّدٍ، فإنّه إن تَزِلَّ لهم قدم بكثرة ذنوبهم تثبت لهم أُخرى بمحبّتهم، فإنّ مُحبَّهم يعود إلى الجنّة ومبغضهم يعود إلى النار[565]. ثُمَّ التقوا بأهل البيت^.
قال في معالي السبطين: فلمّا بلغوا أرض كربلاء نزلوا في موضع مصرعه ووجدوا جابر بن عبد الله مع جماعة من بني هاشم وغيرهم، وقد وردوا إلى زيارة الحسين× فتلاقوا في وقت واحد، وأخذوا بالبكاء والنحيب واللطم، وأقاموا العزاء إلى مدّة ثلاثة أيامٍ[566]، وكأنّي بزينب‘ وهي عند قبر أخيها الحسين× تخاطبه:
|
جيتك وجبت الراس ويّاي |
معذور يالمذبوح علماي
فقام جابر ومَن معه واستقبلوهم، فلمّا التقوا قال الإمام زين العابدين×: أنت جابر؟ قال: نعم سيدي، أنا جابر، فقال×: «يا جابر، ههنا قُتل أبو عبد الله، يا جابر، ههنا ذُبحت أطفال أبي، يا جابر، هاهنا والله قُتلت رجالنا، وسُبيتْ نُساؤُنا وأُحرقت خيامُنا».
|
يجابر ما دريت اشصار بينه |
(أبوذية)
|
كسير اومحد إلگلبي يجابر |
|
|
|
|
*** |
|
|
حُملت على الأكوارِ بعدَ خُدورِها |
|
|
المحاضرة الحادية والثلاثون: المصائب من آثار الأعمال
|
كُلّما تعـذلان زدتُ نحـيبا يا خليليَّ إنْ ذكرتُ حبيبا |
***
(نصاري)
|
أويلي من گرب حتفه اوتدانه |
قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾[568].
المقصود من المصيبة: النائبة، تصيب الإنسان كأنّها تقصده، والمراد بما كسبت أيديكم: المعاصي والسيئات، وقوله: ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾ أي عن كثير ممّا كسبت أيديكم وهي السيئات.
والخطاب في الآية اجتماعي موجّه إلى المجتمع، والمراد بالمصيبة التي تصيبهم المصائب العامّة الشاملة، كالقحط والغلاء والوباء والزلازل وغير ذلك.
فيكون المراد أنّ المصائب والنوائب التي تصيب مجتمعكم وتصابون بها إنّما تصيبكم بسبب معاصيكم، والله يصفح عن كثيرٍ منها فلا يأخذ بها.
فالآية في معنى قوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾[569]، وغير ذلك من الآيات الدالّة على أنّ بين أعمال الإنسان وبين النظام الكوني ارتباطاً خاصّاً، فلو جرى المجتمع الإنساني على ما تقتضيه الفطرة من الاعتقاد والعمل لنزلت عليه الخيرات وفُتحت عليه البركات، ولو أفسدوا أُفسد عليهم: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا...﴾[570].
هذا ما تقتضيه هذه السنّة الإلهية إلّا أن ترد عليه سنّة الابتلاء أو سنّة الاستدراج والإملاء فينقلب الأمر.
هذا، ويمكن أن يكون الخطاب في الآية عامّاً، منحلّاً إلى خطابات الأفراد، فيكون ما يُصاب ـ كلّ إنسان ـ بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو عِرضه وما يتعلّق به مستنداً إلى معصية أتى بها، وسيئة عملها، ويعفو الله عن كثير منها.
والمراد بما كسبته الأيدي، المعاصي والسيئات دون مطلق الأعمال.
والمصائب التي تصيب إنّما هي آثار الأعمال في الدنيا لما بين الأعمال وبينها من الارتباط والتداعي[571].
والطريف في الأمر: إنّنا نقرأ في حديثٍ عن الإمام أمير المؤمنين× أنّه نقل عن الرسول’ قوله: «خيرُ آيةٍ في كتاب الله هذه الآية، يا علي ما من خدشِ عودٍ ولا نكبة قدمٍ إلّا بذنب، وما عفا الله عنه في الدنيا فهو أكرم من أن يعود فِيه، وما عاقب عليه في الدنيا فهو أعدل من أن يثني على عبده»[572].
ولو رجعنا إلى سيرة بني البشر لوجدنا شواهد كثيرة محسوسة وملموسة تدلّ على أنّ المصائب ما هي إلّا من آثار أعمالنا ليس غير، اللهمَ إلّا ما قلناه آنفاً من استثناء كونها لأجل الابتلاء، أو ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في آخر البحث.
فيرى الإسلام أنّ للمعاصي التي يقترفها الإنسان دوراً أساسياً فيما يواجهه من متاعب ومصائب في الحياة الدنيا.
ولذا قال أمير المؤمنين× في تفسير هذه الآية: «توقّوا الذنوب، فما من بليةٍ ولا نقص رزق إلّا بذنب، حتّى الخدش والكبوة والمصيبة، قال الله: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾[573].
فلو آمن الإنسان حقّ الإيمان بأنّ ما يقترفه من الذنوب والمعاصي تنعكس عليه بالآلام والمصائب ليس في حياته الأُخروية فحسب، بل وحتّى في حياته الدنيوية أيضاً، لِما أقدم على معصية قط، ولِما تعمّد الإتيان بأيِّ عمل قبيحٍ، وكلّما ترسّخ هذا الإيمانُ، توفّرت الأرضية المناسبة لبناء الإنسان الصالح أكثر فأكثر.
ولذا قال أحد الطلاب من أهل العلم: في أحد الأيام بال ابني الذي يبلغ من العمر سنتين على الفراش، فضربتْه أُمّهُ ضرباً مبرِّحاً حتّى كاد أن ينقطعَ نَفَسُه، وبعد ذلك بساعة ارتفعت حرارة بدنها ارتفاعاً شديداً حتّى اضطررنا على أثر ذلك إلى مراجعة الطبيب، وكلّفنا الدواء والوصفة مبلغاً باهضاً في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، ولم تنخفض حرارتها، بل أخذت ترتفع أكثر، فراجعنا الطبيب ثانية ودفعنا هذه المرّة مبلغاً آخر أقلّ من المبلغ الأول لغرض معالجتها، وكان المبلغ بالنسبة لي مبلغاً ضخماً، وفي الليل ركب سماحة الشيخ رجب علي الخيّاط ـ وكان من العرفاء ـ في سيارتي لنذهب إلى المجلس، وكانت زوجتي في السيارة. قلت: إنَّ زوجتي ارتفعت درجة حرارتها وأخذتها إلى الطبيب ولكن دون جدوى.
فنظر الشيخ وتوجّه بالكلام إلى زوجتي قائلاً:
الأطفال لا يُضربون بتلك الصورة، استغفري ربّك، وطيبّي خاطر الطفل واسترضيه واشتري لـه شيئاً، تتحسّن حالُكِ. وفعلنا ما أمرنا به الشيخ فانخفضت درجة حرارتها[574].
ومثل هذه القصص يوجد الكثير الكثير الذي يطول المقام بذكره وسرده،
وهذا ممّا لا ينبغي الشكّ فيه، وآثاره واضحة جداً للإنسان الملتفت.
ولكن للأسف قد يستنتج البعض من هذه الحقيقة القرآنية استنتاجاً خاطئاً، ويقول بوجوب الاستسلام لأيَّة حادثةٍ مؤسفةٍ، إلّا أنّ هذا الأمر خطير للغاية؛ لأنّه يستفيد من هذا الأصل القرآني التربوي بشكل معكوس، ويستنتج نتيجة تخديرية.
فالقرآن لا يقول أبداً بالاستسلام حِيال المصائب وعدم السعي لحل المشاكل، والركون للظلم والجور والمرض، بل يقول: إذا اشتملتك المصائب بالرغم من سعيك ومحاولاتك لدفعها، فاعلم أنّ ذلك هو كفّارة الذنوب التي قمت بها وارتكبتها، عليك أن تفكّر بأعمالك السابقة، وتستغفر لذنوبك، وتُصلحُ نفسك وتكتشف نقاط ضعفك. ولِذا ورد ـ كما ذكرنا آنفاً ـ في الروايات أن هذه الآية من أفضل آيات القرآن، بسبب تأثيرها التربوي المهم، ولأنّها تقوم بتخفيف هموم الإنسان، وتعيد الأمل وعشق الخالق إلى قلبه وروحه[575].
ولكن ـ مع كلّ ما تقدَّم من البيان التامّ للآية ـ قد يشكل البعض ويقول: إنّ الآية ـ التي نحن بصددها ـ مخالفة لظواهر ما دلّ من بعض الآيات على أنّ موطن جزاء الأعمال هي الدار الآخرة، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾[576] وغيرها من الآيات التي دلّت على أنَّ كلّ مظلمة ومعصيةٍ مأخوذ بها، وأنّ موطن الأخذ هو ما بعد الموت وفي القيامة، إلّا ما غُفر بالتوبة، أو ما أُذهب بحسنة تتبعه، أو بشفاعة في الآخرة، ونحو ذلك[577].
وهذا مدفوع بما ذكرته نفس الآية التي نحن في صددها ـ أعني ما أصابكم من مصيبة ـ إذ قال ﴿وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾، فلو أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤاخذ العباد بما عملوا وارتكبوا من ذنوب ومعاصٍ لكان ما كان من عدم بقاء واحد على وجه الأرض. لكنّ الباري} عفا عن كثير من هذه الأُمور .
وإلّا فماذا يقال في الدعاء الوارد والمنسوب لأمير المؤمنين×، وهو الدعاء المعروف بدعاء كميل، حيث جاء فيه: «اللهمَ اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم» والتي فُسِرت بمثل شرب الخمر[578]. وفي دعاء آخر:«واغفر لي الذنوب التي تورث الندم» التي فُسِرت بقتل النفس المحترمة[579].
ومثل هتك العصم والندم وحبس الدعاء لا يناسب الآخرة، بل هي من شؤون عالم الدنيا، ولا أقلّ من حبس الدعاء، فإنَّ الآخرة دعاؤها لأهلها غير محجوب، وأمّا غيرهم فلا ينفع.
وهناك فوائد تربوية للمصائب لا يمكن التغافل عنها بحالٍ من الأحوال، وإليك الحديث عنها:
فالبلايا والمصائب إذا لم تواجه الإنسان، والمشاكل إذا لم تعترهِ، لا تتفتّح طاقاته ولا تنمو.
ومن فوائدها العظيمة أنّها جرس إنذار؛ لأنَّ الإنسان يغفل عن حقيقته وينسى ضعفه وفقره بمجرّد أن ترقى حالته، ولذا يقول الباري}: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى ﴾[580].
وأمّا ثمراتها في حياة الأنبياء والأوصياء والصالحين فهي ألطاف إلهية وشرط لوصولهم إلى المقامات العالية في الآخرة، قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا...﴾[581].
وما ورد من الروايات في أنّ للعبد مقاماً ومنزلةً عند الله لا ينالها إلّا بالبلايا والمصائب إلى غير ذلك[582].
ولذا فقد ورد في الحديث، أنّه عندما دخل علي بن الحسين× على يزيد بن معاوية، نظر إليه يزيد وقال: يا علي، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم (إشارة إلى أنّ مأساة كربلاء هي نتيجة أعمالكم).
إلا أنَّ الإمام× أجابه مباشرةً: «كلا ما نزلت فينا، إنّما نزل فينا، ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا من أمر الدنيا ولا نفرح بما أوتينا»[583].
فعلى الحسين فليبكِ الباكون ويضجّ الضاجّون ويعجّ العاجّون؛ لأنّه ليس من أمر الدنيا. نعم، ولمثل الحسين فلتُذرف الدموع[584].
يقول الإمام الصّادق×: «بكى عليُّ بنُ الحسين عشرين سنة، وما وضع بين يديه طعام إلّا بكى، حتّى قال له مولاه: جعلت فداك يا بن رسول الله، إنّي أخاف أن تكون من الهالكين، ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ، إنّي لم أذكر مصرع بني فاطمة إلّا وخنقتني العبرة»[585].
وفي ذات يوم دخل عليه أبو حمزة الثمالي وسأله عن بكائه قائلاً: سيدي ما هذا البكاء والجزع؟ ألم يُقتلْ عمُّكَ حَمزة؟ ألم يُقتل جدُّك علي بالسيف؟ (سيدي): إنّ القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. فقال له الإمام×: «شكر الله سعيك يا أبا حمزة، كما ذكرت، القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ولكن يا أبا حمزة، هل سمعت أذناك أم رأت عيناك أنّ امرأة منّا سبيت وهتكت قبل يوم عاشوراء؟ والله يا أبا حمزة، ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلّا وذكرت فرارهن في البيداء من خيمة إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين»[586].
(فايزي)
***
|
هذهِ زينبٌ ومن قبلُ كانَتْ |
المحاضرة الثانية والثلاثون: الشجاعة
|
أدركْ تراتِكَ أيُّها الموتورُ |
وكأنّي بالحوراء زينب‘ تنظر إلى تلك الخيول وهي تدوس أضلع سيد الشهداء أبي عبد الله×:
(عاشوري)
گلبي يبـو حمزه تراهو اتفطّـر وذاب
مثل المصيبة اللي دهتني محد إنصاب
ذيچ الأقمار اللي ابمنازلنه يزهرون
والليل كلّه من العبادة ما يهجعون
سبعة وعـشرة عاينتهم كلّهم اغصون
فوگ الوطيّه مطرّحين ابحر الاتراب
اولوشفت جسـم اللي على امسناة مطـروح
وذاك الشباب اللي بصبح العرس مذبوح
اولوشفت الأكبر مالمتني ابكثرة النوح
مـا خلتنّـه كـربله شيب ولا شـاب
بعيني نظرت احسين بيده الطفل منحور
وامّه الرباب اتعاينه وادموعها اتفـور
وگلـوبنه فتها بـونينه اوعينه إدور
وكلّما طلع منه بدر للمعركة غاب
ومصيبـة اللّي هيّجـت حـزني عليَّ
عاينت صدر احسين تحت الأعوجيه
اوحرگوا خِيَمنه اوسيّروا زينب سبيه
شحچي يبو حمزه اوشعدد من هالمصـاب
ما نكّست راسي لجل ذيچ الصناديد
مـاگصّـروا بالغاضـريه زلزلوا البيـد
نكّسه الراسي ادخول زينب مجلس يزيد
حسـره اومن نوح اليتامه راسها شاب
|
يحسين خويه اشيوجعك گول |
ولكن سلني ما حال النسوة والأطفال بعد مصرع حُماتهم:
(بحر طويل أو تغريد الحزين)
يفترن خوات احسين من خيمه لعـد خيمه
اوكلّ خيمه تشب ابنار ردن ضربن الهيمه
ينخن وين راحـوا وين ماكو بالعده شيمه
والسجاد اجو سحبوه اودمعه اعلى الوجن ساله
***
(نعي مجاريد)
|
فرّن اوكلّ وحده ابمشيها |
***
روي عن إمامِنا الصّادق× أنّه قال:
«ثلاثةٌ لا تعرفُ إلّا في ثلاثِ مواطن؛ لا يُعرفُ الحليمُ إلّا عِندَ الغَضب، ولا الشُجاعُ إلّا عِندَ الحربِ، ولا أخٌ إلّا عِندَ الحاجةِ»[589].
الشجاعةُ من المعاني العظيمة، فالشجاعة هي قوّة القلب والإقدام والجرأة والصبر في وقت الشدّة، وقد تكون الشجاعة باللسان، وقد تكون باليد، وقد تكون بالبنان، كأن يكتب الإنسان شيئاً يظهر فيه حقيقة من الحقائق الخطيرة ولو كانت لا ترضي القوم بل تسخطهم، والشجاعة تحتاج إلى التحديد وإلّا إذا زادت عن حدّها انقلبت إلى التهوّر، وبخلاف ذلك ما لو نزلت عند الإنسان صفة الشجاعة إلى دون المتعارف، فسوف يكون الإنسان جباناً، وهكذا الحال في باقي الصفات، فكلُّ صفةٍ لها حدّ معيّن، فالكرم ـ مثلاً ـ إذا زاد عن حدّه الطبيعي المناسب لشأن الإنسان سوف يكون إسرافاً وتبذيراً، وإذا نزل دون المتعارف سوف يكون بخلاً، وهكذا الحال في الصفات الباقية. إلّا أنَّ هناك آفة للشجاعة، كما في باقي الصفات أيضاً، فإنَّ لكل شيء آفة، كما روي عن الإمام أمير المؤمنين× بيان آفة القوّة والشجاعة، حيث قال: «وآفة القوي استضعاف الخصم، وآفة الشجاعة إضاعة الحزم»[590].
ثُمَّ إنّ هناك عدّة صفات تلازمُ الشجاعة منها:
الأول: الصدق
فعن الإمام أمير المؤمنين× أنّه قال: «لو تميّزت الأشياء لكان الصدق مع الشجاعة، وكان الجبن مع الكذب»[591].
ولذا ترى الإنسان الشجاع لا يكذب؛ لأنَّ الإنسان إنّما يكذب بسبب جبنه، وإلّا فما الداعي ليخفي الإنسان الحقائق؟ ليس هناك سبب سوى أنّه يخاف من الحقيقة، أو أنَّها لا تصبّ في مصلحته، إلى غير ذلك ممّا هو معلوم بالبداهة.
الثاني: السخاء والكرم
الشجاع تجده كريم النفس وسخي اليد عادةً؛ لأنّه لا يخاف من الفقر ولا يخشى منه؛ ولذا يقدم على السخاء والجود.
الثالث: قول الحقّ وطاعة الله
وهاتان من أهمّ الصّفات التي ينبغي أن تلازم الشجاعة، وهي أن يكون الإنسان قويّاً وشجاعاً في قول الحقّ مطيعاً لله تبارك وتعالى.
ومن هنا رُوي عن الإمام الصادق× عن أبيه عن جدّه^ قال: مرّ رسول الله’ بقوم يرفعون حجراً، قال ما هذا؟ قالوا: نعرف بذلك أشدّنا وأقوانا. فقال’: «ألا أخبركم بأشدِّكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسولَ الله، قال: أشدّكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قول الحقّ، وإذا قَدِرَ لم يتعاطَ ما ليس له بحقّ»[592].
وحريّ بالإنسان الشجاع أن يكون عنده هدف مقدَّس، وغاية نبيلة، ونيّة خالصة لله تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان الشجاع مشخّصاً للهدف الإلهي حتّى يعطى ثوابها، ويُختم لصاحبِها بالشرفِ الرفيعِ، قال المتنبي:
|
لا يسلم الشـرفُ الرفيعُ من الأذى |
فقول الحقّ وطاعة الله تبارك وتعالى صفتان تلازمان الشجاعة الحقيقية التي يريدها الله تبارك وتعالى، حتّى روي: «حقّ عند سلطانٍ جائر» أو «أنّ من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطانٍ جائر»[594].
هذه هي الشجاعة التي امتلكتها حتّى نساء المسلمين، حُكي أنّه خرج الحجّاج يوماً ما إلى الصّحراء والتقى بجاريةٍ عربيّةٍ، فقال لها: هل تحفظين القرآن؟
قالت: نعم، وبدأت تقرأ: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجاً.
فغضب الحجاج، وتلاها صحيحة وقال لها: لقد حرّفت الآية، إنّها: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾، وليس يخرجون من دين الله.
فقالت له: كان ذاك في عهد رسول الله’، أمّا في عهدك فهكذا يخرج الناس من الدين بسبب أعمالك»[595].
هذه مرتبة عالية من الشجاعة في أن تواجه امرأةٌ والياً فضّاً غليظاً ليس عنده إلّا لغة النطع والسيف.
وصفةُ الشجاعة برزت وبشكل مثير للانتباه في أمير المؤمنين× حتّى شهد بها العدو قبل الصديق ـ والفضل ما شهدت به الأعداء ـ فقد ظهر منه× من الشجاعة ما حيّر العقول، وأذهل النفوس في مواطن عديدة وكثيرة بين يدي الرسول الأكرم’ في يوم بدر، والذي كان بعد مرور ثمانية عشر شهراً من قدوم النبي’ إلى المدينة المنورة، تلك الواقعة حصلت فيها المعجزات وكانت تعتبر المعركة الأُولى والكبرى بالنسبة للمسلمين، قال تعالى فيها: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾[596].
وبعد أن انهزم المشركون فيها أخذوا يعدّون العدّة والعدد ـ كردِّ فعل لما أصابهم في بدرٍ ـ ليُرجعوا إلى وجوههم الماء الذي أُريق منها في معركة بدر، فتجمّعوا وبذلوا الأموال وجيّشوا الجيوش، وتولّى ذلك أبو سفيان بنفسه، وقصدوا النبيّ’، وأمير المؤمنين× بالمدينة، فخرج النبيّ بالمسلمين، ودخل النفاق والشك والريب قلوب جماعة منهم، فرجع ما يقارب من ثلثهم إلى المدينة، وبقي النبي’ في سبعمائة من المسلمين، وحصلت الهزيمة وانكسر جيش المسلمين، ولم يبقَ مع النبي’ إلّا نفر قليل يتزعّمهم أمير المؤمنين×.
وذكر أهل السير قتلى (أُحد) مِن المشركين، فكان جلُّ جمهورهم مقتولين بسيف أمير المؤمنين×، وكان الفتح له، وسلامة رسول الله’ من المشركين بسبب سيفه×[597].
ثمَّ حصلت معركة الخندق وخلاصتُها: أنّ جماعة من اليهود جاؤوا إلى أبي سفيان ـ لعلمهم بعداوته للنبي’ ـ وسألوه المعونة فأجابهم وجمع لهم قريشاً وأتباعهم من كنانة وتهامة وغطفان وأتباعها من أهل نجد، واتّفق المشركون مع اليهود وأقبلوا بجمعٍ عظيمٍ فاشتدّ الأمر على المسلمين، فحفر المسلمون خندقاً وخرج النبيّ’ بالمسلمين وهم ثلاثة آلاف، والمشركون مع اليهود يزيدون على عشرة آلاف، وجعلوا الخندق بينهم وبين المسلمين، وركب عمرو بن عبد ود ومعه فوارس من قريش، وأقبلوا حتّى وقفوا على أضيق مكان في الخندق، ثُمَّ ضربوا خيلهم فاقتحمت وصاروا بين الخندق والمسلمين فخرج إليهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، فقال عمرو: «هل من مبارزٍ؟» قال أمير المؤمنين×: «أنا»، فقال لـه النبيّ’: «إنّه عمرو» فسكتَ، ونادى عمرو: «هل من مبارزٍ؟» فقال أمير المؤمنين×: «أنا له يا رسول الله»، فقال’: «إنّه عمرو»، فسكتَ، ونادى عمرو ثالثة، فقال أمير المؤمنين×: «أنا له يا رسول الله» فقال’: «إنّه عمرو». وكلّ ذلك يقوم علي× فيأمره النبي’ بالثبات انتظاراً لحركة غيره من المسلمين، هذا وهم يسمعون كلام النبي’ ونداء عدو الله وعدو رسوله’، وطال نداء عمرو وهو يطلب المبارزة وتتابع قيام أمير المؤمنين×، فلمّا لم يقدم أحد من الصحابة قال النبي’ لعلي×: «ادنُ مِني يا علي»، فدنا منه، فنزع عمامته عن رأسه وعمّمه بها، وأعطاه سيفه، وقال: «امضِ لشأنك». ودعا له، ثُمَّ قال: «برز الإيمان كُلُّه إلى الشرك كُلِّه».
فدنا أمير المؤمنين× نحو عمرو حتّى انتهى إليه فقال له: «يا عمرو، إنَّك كنت تقول: لا يدعوني أحد إلى ثلاثٍ إلّا قبلتها، أو واحدة منها»، فقال عمرو: أجل، قال أمير المؤمنين×: «إنّي أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحمَّداً رسول الله، وأن تسلم لربّ العالمين»، قال عمرو: أخّر هذه عني، فقال أمير المؤمنين×: «أما أنّها خير لك لو أخذتها»، ثُمَّ قال×: «ههنا أُخرى»، قال: وما بقي؟ قال ×: «ترجع من حيث أتيت»، قال: لا تتحدّث نساء قريش عني بذلك أبداً، قال×: «فها هنا أُخرى»، قال: وما هي؟ قال×: «أبارزك أو تبارزني»، فضحك عمرو وقال: إنّ هذه الخصلة ما كنتُ أظن أحداً من العرب يطلبها منّي، وأنا أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك، وقد كان أبوك نديماً لي، فقال علي×: «وأنا كذلك، لكنّي أُحبُّ أن أقتلك ما دمت أبيّاً للحقّ»، فحمى عمرو ونزل عن فرسه وضرب وجهه حتّى نفر، وأقبل على أمير المؤمنين× مسلطاً سيفه وبادره بضربة فلبث السيف في ترس علي× وضربه أمير المؤمنين×.
قال جابر بن عبد الله الأنصاري&: فتجاولا وثارت بينهما غُبرة، وبقيا ساعة طويلة لم نرهما ولا سمعنا لهما صوتاً، ثُمَّ سمعنا التكبير، فعلمنا أن علياً × قد قتل عمراً، وسُرَّ النبي’ سروراً عظيماً لمّا سمع صوت أمير المؤمنين× بالتكبير، وكبّر وسجد لله تعالى شكراً، وانكشف الغبار، وعبر أصحاب عمرو الخندق وانهزم عكرمة بن أبي جهل وباقي المشركين، وكانوا كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا...﴾[598].
هذا غيض من فيض، وقطرة من بحر شجاعة أمير المؤمنين×، وما لم نذكره أكثر بكثير ممّا ذكرناه. فأصبحت بيوت مشركي قريش تطلب الثأر من أمير المؤمنين×؛ لأنّه لم يترك بيتاً إلّا وقد وتره، فأخذوا يتحيّنون الفرصة به× إلى أن جاء الموعد المحدّد الذي رسمه أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أمير المؤمنين×، وذلك في ليلة التاسع عشر من شهر رمضان. أتى أمير المؤمنين× بعد أن صلّى المغرب وما شاء من النفل ليفطر، وكان يفطر ليلةً عند الحسن، وليلةً عند الحسين، وليلةً عند عبد الله بن جعفر، فقدّمت إليه ابنته أُمّ كلثوم (زينب) قرصين من شعير، وقصعة فيها لبن وجريش ملح، فقال لها: «قدّمتِ أدامين في طبق واحد، وقد علمت أنّني متّبعٌ ما كان يصنعُ ابنُ عمّي رسول الله’، ما قُدّم إليه أدامان في طبق واحد حتّى قبضه الله إليه مكرّماً، ارفعي أحدهما فإنّ مَن طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله»، فرفعت اللبن الحامض بأمر منه، ثُمَّ أكل قليلاً وحمد الله كثيرا،ً وأخذ في الصلاة والدعاء إلى أنْ غفت عيناه فاستيقظ وقال لأولاده: «رأيت النبي’ فشكوت إليه ما أنا فيه من التبلّد بهذه الأُمَّة فقال لي: ادعُ عليهم فإنّ الله تعالى لا يرد دعاءك، فقلت: اللهمَ أبدلني بهم خيراً وأبدلهم بي شراً». وكان× يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول: «هي والله الليلة التي وعدنيها حبيبي رسول الله’». وكان يكثر من قوله: «لاحول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم»، حتّى ذهب بعض الليل ثُمَّ جلس للتعقيب فهوّدت عيناه وهو جالس، ثُمَّ انتبه مرعوباً فقال لأولاده: «إنّي رأيت رؤيا أهالتني وأريد أن أقصّها عليكم»، قالوا: وما هي؟ قال: «إنّي رأيت الساعة رسول الله’ في منامي وهو يقول: يا أبا الحسن، إنِّك قادم علينا عن قريب يجيء إليك أشقاها فيخضّب شيبتَك من دم رأسك، وأنا والله، مشتاق إليك وإنّك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان، فهلُمَّ إلينا فما عندنا خير لك وأبقى» فلمّا سمع أولادُه كلامَه ضجّوا بالبكاء والنحيب وأبدوا العويل، فأقسم عليهم بالسكوت فسكتوا ثُمَّ عاد إلى البكاء من خشية الله والتضرّع والعبادة.
تقول أُمّ كلثوم: «سمعتُه يقول ـ بعد ما نظر إلى الكواكب ـ: والله، ما كذّبتُ ولا كُذّبت وإنّها الليلة التي وعدتُ بها. إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم»، وصلّى على النبيّ’ واستغفر الله كثيراً، فلمّا رأيته كذلك قلقاً متململاً أرقت معه ليلتي، وقلت: «يا أبتاه، ما لي أراك هذه الليلة لا تذوق طعم الرقاد؟ قال: يا بنية، إنّ أباك قتل الأبطال وخاض الأهوال وما دخل الخوف له جوفاً، وما دخل قلبي رعب أكثر ممّا دخل في هذه الليلة. ثُمَّ قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون». فقلت: «يا أبتاه، ما لك تنعى نفسك هذه الليلة؟ قال: يا بنية، قد قرب الأجل وانقطع الأمل».
تقول أمّ كثلوم: «فبكيت، فقال لي: يا بنيّة، لا تبكي فإنّي لم أقل ذلك إلّا بما عهد إليَّ النبيّ’. ثُمَّ قال: يا بنية، إذا قرب الأذان فأعلميني. فجعلت أُراقب الأذان، فلمّا لاح الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماء، فأسبغَ الوضوء وقام ولبس ثيابه، وفتح الباب ونزل إلى الدار، وكان في الدار إوَز قد أُهدي إلى أخَويَّ الحسن والحسين، فلمّا نزل خرجنَ وراءَه ورفرفنَ وصحْنَ في وجهه ولم يَكُنَّ قد صِحْنَ في وجهه من قَبْل، فقال×: لا إله إلا الله، صوائح تتبعها نوائح وفي غداةِ غدٍ يظهرُ القضاء. فلمّا وصل إلى الباب وعالجه ليفتحَه تعلّق مئزره بالباب فانحلَّ حتّى سقط، فأخذه وشدَّه وهو يقول:
|
أشدد حيازيمكَ للموت فـإنّ الموت لاقيكا |
ثُمَّ فتح الباب وخرج متوجّهاً إلى المسجد، وكان عدو الله ابن ملجم متخفّياً في بيوت الخوارج بالكوفة يتحيّن الفرصة بأمير المؤمنين×، وقد اتّفقت معه قطام أنّه إذا قتل علياً تتزوجه؛ لأنّ ذلك يشفي غليلها ويطفي جمرة غيظها، إذ إنَّ أمير المؤمنين× قتل أباها وأخاها في النهروان. وانبرى لمساعدة ابن ملجم شخصان آخران من الخوارج هما: شبيب بن بجرة، ووردان بن مجالد، واتّفقوا جميعاً على أن تكون ليلة التاسع عشر ليلة اغتيال الإمام×، فجاء ابن ملجم (لعنه الله) إلى المسجد ونام مع الناس مُخفِياً سيفه تحت إزاره، ولمّا وصل الإمام إلى المسجد صلّى ركعتين، ثُمَّ صعد المئذنة فأذّن، ثُمَّ نزل وهو يُسبّحُ الله ويكثر من الصلاة على النبي’، وكان من عادته أنّه يتفقد النائمين في المسجد، وهو يقول: «الصلاة يرحمك الله، إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر»، حتّى وصل إلى ابن ملجم (لعنه الله) وهو نائم على وجهه، فقال له: «يا هذا، قم من نومك فإنّها نومة يمقتها الله، وهي نومة الشياطين». ثُمَّ اتّجه نحو المحراب يصلّي، وكان يطيلُ الركوع والسجود في صلاته، فقام الشقي ابن ملجم حتّى وقف بإزاء الأسطوانة التي يصلي عندها الإمام، فأمهله حتّى ركع وسجد السجدة الأُولى ورفع رأسه منها، فتقدّم اللعين وأخذ السيف وهزه، ثُمَّ ضرب الإمام× على رأسه الشريف فوقع الإمام على وجهه قائلاً: «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله». ثُمَّ صاح: «فزتُ وربِّ الكعبة، قتلني ابن اليهودية».
(نصاري)
|
بالمحراب اويلي طاح أبو احسين |
آجركم الله، فاصطفقت أبواب الجامع، وضجّت الملائكة في السماء، وهبّت ريح عاصفة سوداء مظلمة، ونادى جبرئيل بين السماء والأرض بصوت يسمعه كلّ مستيقظ: «تهدَّمت والله أركان الهدى، وانطمست والله نجوم السماء وأعلام التُقى، وانفصمت والله العُروة الوثقى، قُتلَ ابن عمّ المصطفى، قُتلَ الوصي المجتبى، قُتلَ عليُّ المرتضى، قُتل سيّد الأوصياء، قتله أشقى الأشقياء»، فلمّا سمعت أمّ كلثوم نعي جبرائيل لطمت على وجهها وخدّها، وصاحت وا أبتاه وا علياه.
(فايزي)
الله يالناعي إفجعت گلبي اومردتـه
يا ريت صوتك لا عَلَي مرّ اوسمعته
چن عَودي ماتمم ابمحرابه سجدته
الله يالناعي افجعتنه ابهذا المصـاب
گلـها يويلي راح أبوچ اوهلّي العين
صابه المرادي ابسيفه اوطر راسه نصين
من سمعته صاحت يخويه حسن واحسين
گوموا لبونه اتلاحگوا بالمسجد انصاب
فخرج الحسنان إلى المسجد وهما يناديان: «وا أبتاه! وا علياه! ليت الموت أعدمنا الحياة»، حتّى وصلا إلى المسجد، وإذا بالإمام في محرابه والدماء تسيل من رأسه على وجهه وشيبته، فتقدّم الحسن× وصلّى بالناس وصلّى أمير المؤمنين× إيماءً من جلوس، وهو يمسح الدم من وجهه وكريمته، يميل تارة ويسكن تارة أُخرى، والحسن ينادي: «وا انقطاع ظهراه، يعزُّ عليَّ أن أراك هكذا»، ثُمَّ شاع الخبر في الكوفة، فهرع الناس رجالاً ونساءً حتّى المخدرات خرجن من خدورهن إلى الجامع، وهم ينادون: وا إماماه! قُتل والله إمام عابد مجاهد لم يسجد لصنم، كان أشبه الناس برسول الله’، فدخل الناس إلى المسجد، فوجدوا الحسن ورأس أبيه في حجره، وقد شدّ الضربة وهي لم تزل تشخب دماً، ووجهه قد زاد بياضاً بصفرة، وهو يرمق السماء بطرفه ولسانه يُسبّح الله ويوحّده، ثُمَّ أمر أن يحملوه من ذلك المحراب إلى موضع مصلاه في منزله.
قال محمد بن الحنفية: فحملناه إليه والناس حوله، وهم في أمر عظيم باكون محزونون قد أشرفوا على الهلاك من شدّة البكاء والنحيب، وكان الحسين× يبكي ويقول: «وا أبتاه، مَن لنا بعدك، ولا يوم كيومك إلّا يوم رسول الله’»[599].
وكأنّي بزينب لمّا نظرت إلى أمير المؤمنين وهو محمول على الأكتاف نادت: وا أبتاه، وا علياه!
(مجاريد)
|
ونت اونادت يلمجبلين |
(أبوذية)
|
اشلون اللي رسول الله وصابه[600] |
***
|
شهرُ الصّيام بِهِ الإسلامُ قد فُجعا |
المحاضرة الثالثة والثلاثون: آية الولاية
(موشّح)
|
نوح يا ناعي اودمعتك سيلها |
***
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾[602].
جاء في تفسير مجمع البيان ـ وتفاسير وكتب أُخرى ـ نقلاً عن عبد الله بن عبّاس أنّه قال: إنّه كان في أحد الأيام جالساً إلى جوار بئر زمزم ويروي للناس أحاديث النبيّ’، فتقرّب إليهم ـ فجأةً ـ رجلٌ كان يرتدي عمامة، ويضع على وجهه نقاباً، وكان كلّما تلا ابن عبّاس حديثاً عن النبيّ’ قال هو حديثاً عن النبيّ. مستهلاً قوله بعبارة: «قال رسول الله...» فأقسم عليه ابن عبّاس أن يعرِّف نفسه، فرفع هذا الشخص النقاب عن وجهه وصاح: أيّها النّاس مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني فأنا جُندُب بن جنادة البدري أبو ذرّ الغفاري، سمعت رسول الله’ بهاتين وإلّا صُمّتا، ورأيته بهاتين وإلّا فُعميتا، يقول: «عليّ قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور مَن نصره، مخذول مَن خذله» وأضاف أبو ذرّ: أما إنّي صلّيت مع رسول الله’ يوماً من الأيام صلاة الظهر، فسأل سائلٌ في المسجد فلم يعطه أحد، فرفع السائل يده إلى السماء، وقال: اللهمَ اشهد بأنّي سألت في مسجد رسول الله’ فلم يعطني أحدٌ، وكان عليّ أمير المؤمنين× راكعاً، فأومأ إليه بخنصره اليمنى، وكان يتختّم فيها، فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين النبيّ’، فلمّا فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء، وقال: «اللهمَ موسى سألك فقال: ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴾ فأنزلت عليّه قرآناً ناطقاً: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ اللهمَ وأنا مُحمّدٌ نبيّك وصفيُّك، اللهمََّ فاشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واجعل لي وزيراً عليّاً أشدد به ظهري». قال أبو ذرّ&: فما استتمّ رسول الله’ كلامه حتّى نزل جبرائيل من عند الله} فقال×: يا مُحمّد، إقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: إقرأ: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾[603].
وفي مصنفات بعض علمائنا: إنّ عمر بن الخطّاب قام ووقف أمام النبيّ’ وقال: يا رسول الله، أجائزٌ هذا؟ إنّ عليّ بن أبي طالب يعبث في صلاته، ويشير إلى السائل أن ينتزع الخاتم من يده ـ وأراد أن يسند إلى الإمام سيئةً ـ؟ فقال النبيّ’: «والله الذي لا إله إلّا هو إنّه لجائز لعليّ أن يتصدّق بالصلاة وهو في حالة الركوع».
وفي ذلك اليوم العظيم ـ يوم الرابع والعشرين من شهر ذي الحجّة المبارك، يوم تصدَّق فيه أمير المؤمنين× وفرض الله ولايته على جميع المسلمين والمسلمات فرضاً واجباً ـ قام حسّان بن ثابت الأنصاري وقال: يا رسول الله، فداؤك أبي وأمي! أتأذن لي أن أنشد أبياتاً في هذه المناسبة؟
فقال’: «شأنك يا حسّان»، فأنشد حسّان تلك الأبيات التي اشتُهرت بعد ذلك:
|
أبا حسنٍ تفديك نفسـي ومُهجتي |
وممّا لا شك فيه أنّ هذا الشعر صدر من حسّان بن ثابت، فاُنظر إليه بعين الإنصاف ماذا يقول:
|
فأنـزلَ فيكَ الله خيرَ ولايـةٍ |
وكانت القضّية واضحةً بدرجةِ أنّ حسّان يقومُ ـ وعلى البداهة ـ فيقرأ هذه الأبيات.
وقد وردت هذه الأبيات باختلافات طفيفة في كتب كثيرة منها: كتاب تفسير (روح المعاني) للآلوسي، وكتاب (كفاية الطالب) للكنجي الشافعي وكتب كثيرة أُخرى[605].
ففضائل أمير المؤمنين× لا يُحصيها كتابٌ ولا كاتبٌ ولا شاعرٌ ولا مـفوّه، لا يُحصيها إلّا الله تبارك وتعالى.
ابتدأت هذه الآية بكلمة: ﴿إِنَّمَا﴾ التي تفيد الحصر، وبذلك حصرت ولاية أمر المسلمين في ثلاثٍ هم: الله}، ورسوله’، والذين أمنوا وأقاموا الصلاة وأدّوا الزكاة في حالة الركوع في الصلاة كما تقول الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾.
ولا شكّ في أنّ الركوع المقصود في هذه الآية هو ركوع الصلاة، ولا يعني الخضوع؛ للدلالة عليه من الروايات حيث ذكرت أنّ الإمام أمير المؤمنين× تصدّق بخاتمه في حال الصلاة وبالخصوص في حال الركوع، كما ذكرنا ذلك في سبب النزول في صدر المحاضرة، ثُمَّ إنّ القوم اتّفقوا على أنّ الذي أعطى خاتمه هو صهر رسول الله’، ولا يضرّ سواء فُسّر الركوع بالركوع المصطلح، أم فُسّر بالخضوع والخشوع، أو غير ذلك.
ولو رجعنا إلى اللغة وعملية وضع الألفاظ للمعاني واستعمالها يكون استعمال الركوع في معنى الخضوع والخشوع استعمالاً مجازياً يحتاج إلى قرينة؛ إذ المعنى الحقيقي للركوع هو الركوع الذي بمعنى الانحناء وطأطأة الرأس.
ثُمَّ إنّهم قد أشكلوا على التصدّق في أثناء الركوع بما مفادهُ: تقولون بأنّ أمير المؤمنين× إذا قام للصلاة يصل به الخشوع والخضوع إلى درجة أنّ المسلمين إذا أرادوا انتزاع سهم منه× لا يستطيعون إلّا في وقت الصلاة، فإنّه يذوب في ذات الله، فكيف توجّه إلى السائل وأعطاه الخاتم، أليس ذلك معناه أنّه انصرف عن ذات الله وعظمته وجلاله حين التفاته إلى السائل وإشارته إلى الخاتم وغير ذلك[606].
وهذا الكلام لا قيمة له؛ لأنّ إعطاء الخاتم وهو في الصلاة هو تنقُّل بين طاعة وطاعة أُخرى، وهذا العمل ـ التصدّق بالخاتم ـ بنفسه عبادة ولم يخرج عن عنوان العبادة والعبودية.
ثُمَّ إنّ سماع صوت السائل والسعي لمساعدته لا يعتبر دليلاً على الانصراف والتوجّه إلى النفس، بل هو عين التوجّه إلى الله، ومن الضروري أن نؤكّد هنا ونقول: إنّ الذوبان في التوجّه إلى الله، ليس معناه أن يفقد الإحساس بنفسه، ولا أن يكون بدون إرادة، بل الإنسان بإرادته يصرف عن نفسه التفكير في أيّ شيءٍ لا صلة له بالله تعالى[607].
كما لا شكَّ أنَّ كلمة (الوليّ) الواردة في هذه الآية، لا تعني الناصر والمحبّ؛ لأنَّ الولاية التي هي بمعنى الحبّ والنصرة لا تنحصر فيمَن يؤدّون الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، بل تشمل كلّ المسلمين الذين يجب أن يتحابّوا فيما بينهم وينصر بعضهم البعض، حتّى أولئك الذين لا زكاة عليهم، أو لا يمتلكون ـ أساساً ـ شيئاً ليؤدّوا زكاته، فكيف يدفعون الزكاة وهم في حالة الركوع؟! هؤلاء كلّهم يجب أن يكونوا أحبّاء فيما بينهم ينصر بعضهم البعض الآخر.
ومن هنا يتّضح لنا أنّ المراد من كلمة (ولي) في هذه الآية، هو ولاية الأمر والإشراف، وحقّ التصرُّف والزعامة المادّية والمعنوية، خاصّة وقد جاءت مقترنة مع ولاية النبيّ’ وولاية الله ـ تبارك وتعالى ـ حيث جاءت الولايات الثلاث في جملة واحدة.
وبهذه الصورة فإنّ الآية تعتبر نصّاً قرآنيّاً يدلُّ على ولاية وإمامة عليّ بن أبي طالب× للمسلمين[608]. هذا الإمام أمير المؤمنين× أعطى الزكاة للسائل وهو راكع، وأعطى رأسه لله وهو ساجد، والجود بالنفس أقصى غاية الجود.
ما حال الإمام في مثل هذه الليلة ـ ليلة العشرين ـ؟!
في هذه الليلة كان أمير المؤمنين× في داره بين أولاده وأهل بيته، إلّا أنّ الدماء كانت تنزف من رأسه الشريف.
يقول مُحمّد بن الحنفية: فبينما نحن في ليلة العشرين من شهر رمضان عند أبي عليّ× وقد سرى السمّ في بدنه الشريف، وكان يُصلّي تلك الليلة من جلوس، وهو يعزّينا بنفسه ويوصينا بما هو أهله، من أفعال الخيرات، واجتناب الشرور، ويكثر من ذكر الله تعالى وقولِ: «لا حول ولا قوة إلّا بالله العليّ العظيم».
يقول الأصبغ بن نباته: «دخلت على الإمام فإذا هو مستند ومعصوب الرأس بعمامة صفراء قد نزف دمه، واصفرّ وجهه، فما أدري وجهه أشدّ صفرة أم العمامة، فأكببتُ عليه فقبّلته وبكيت، فقال لي: لا تبكِ يا أصبغ فإنّها الجنّة.
قلت: جُعلت فداك يا أمير المؤمنين، ثُمَّ نظر الإمام إلى أولاده فرآهم تكاد أنفسهم تزهق من النوح والبكاء، فجرت دموعه على خديه ممزوجه بدمه.
وقال×: «أتبكيا عليَّ؟ ابكيا كثيراً واضحكا قليلاً، أمّا أنت يا أبا مُحمّد، ستُقتل مظلوماً مسموماً مضطهداً، وأمّا أنت يا أبا عبد الله، فشهيد هذه الأُمَّة، وسوف تذبح ذبح الشاة من قفاك، وتُرضّ أعضاؤك بحوافر الخيل، ويُطاف برأسك في مماليك بني أُميّة، وحريم رسول الله’ تُسبى وأنّ لي ولهم موقفاً يوم القيامة».
وأقبلت إليه زينب وأُمّ كلثوم وهما يندبانه ويقولان:
مَن للصغير حتّى يكبر؟ ومَن للكبير بين الملا، يا أبتاه، حزننا عليك طويل، وعبرتنا لا تبرح ولا ترقأ.
فضجَّ مَن كان حاضراً بالبكاء، وفاضت دموع أمير المؤمنين× على خديه، وهويُقلّبُ طرْفه وينظر إلى أهل بيته:
|
ها لليله أبـونه أمسى بشـدّه |
وفي هذه الليلة أُحضر عنده عروةُ السلولي، وكان أعرف أهل زمانه بالطبّ، فذبح شاة، وأخرج منها عِرقاً فأدخله في جراحة الإمام ثُمَّ أخرجه وإذا عليه بياض الدّماغ فقال الطبيب ـ بعد أن استعبر وبكى ـ:
إعهد عهدك يا أمير المؤمنين، فإنّ الضربة وصلت إلى الدماغ[609]:
|
بس ما فحص جرحـه طبيبه |
وكأنّي بزينب تسأل أخاها الحسن× عن أبيها× وما قاله الطبيب:
|
ياحسن والدنه اوذخرنـه |
اومـن والـدچ گطعــي الظـــنّه
(أبوذية)
|
اوراسه ابسيف أشقى النّاس ينصاب |
***
|
مُصابٌ قد لوى للدينِ جيداً وهدَّ مِن الهُدى رُكناً مشَيداً |
المحاضرة الرابعة والثلاثون: آية التطهير
|
ألا مَن هدَّ رُكنَ المُسلمينا |
|
إجه العيد ريته لا إجانه |
الحـــامي الحمـــه الخــالي مچــانه
***
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾[611].
العصمة ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية والميل إليها مع وجود القدرة على ذلك، وهي واجبة على لمـَن وجبت لـه الطاعة، وبيده مقاليد أُمور الأُمَّة الدينيّة والدنيويّة، وأنّ الله} هو مَن يختار النبيّ والإمام؛ لأنّه أعلم بخلقه، ويريد الله إتمام دينه وتوضيحه لمخلوقاته عن طريق أُناس معصومين من الخطأ[612].
ومن هنا لا يمكن أن نلتزم أو يلتزم أيُّ عاقل بأنّ يُلقي تعيين الإمام إلى الأُمَّة؛ لقصور إداراكات البشر عن الوصول إلى الصحيح الواقعي وتمييزه من السقيم كذلك؛ ولذا تجد أنّ البشر اليوم تارةً ـ وبحسب المنظار العلمي ـ يتوصّلون إلى نظرية، تعكف على دراستها الأجيالُ عشرات بل مئات السنين، ثم بعد مدة مديدة من الزمن ينكشف لهم بأنّها كانت خاطئة، ويؤتى بنظرية جديدة على نقيض تلك الأُولى، بل يُستهزأ بعقل وعلم كلّ إنسان ينتصر لتلك النظرية الأُولى مع أنَّ الأجيال عكفت عليها مئات السنين.
فالذي ينبغي أن يقال: إنّ النّاس قاصرون ـ بكلّ ما تعطي هذه الكلمة من معنى ـ عن إدراك ما ينفعهم واقعاً ممّا ليس كذلك، وهذا أمر يدركه العقل ولا يمكن لأي عاقل أن ينكره؛ لأنّه بالبديهيّ أشبه.
فالحاصل: لا بدّ أن يقع تعيين الإمام والخليفة من قِبل الله تبارك وتعالى، فإذا عرفنا هذا فما هي المواصفات التي ينبغي أن يتّصف بها الإمام؟
وهذا السؤال واسع النطاق؛ إذ هناك من الصفات ماتعجز الأقلام عن ذكرها مع كونها من صفات الإمام، ولكنَّ المهم هنا في هذه المحاضرة بيان صفة مهمّة يجب أن يتّصف بها الإمام الخليفة بعد الرسول’، وهي صفة العصمة التي قد أشرنا إلی تعريفها إجمالاً.
ولنرجع إلی الآية المباركة ولنبحث فيها، ولنرى هل تدلّ علی العصمة أو لا؟ ولودلّت علی العصمة يأتي السؤال الثاني وهو: فيمَن نزلت ؟ إلی غير ذلك.
إنّ التعبير بـ (إنّما) ـ والذي يدلّ عادة ً علی الحصر ـ دليل علی أنّ هذه المنقبة خاصّة بأهل البيت^، والمقصود من أهل البيت المذكورين في الآية القرآنية هم خصوص أهل بيت النبيّ’ دون أزواجه’، لأنّ كبار علماء العامّة قد رووا في غير واحدٍ من صحاحهم، ومنهم أبوداود في صحيحه ـ علی ماذكره أفذاذ العلماء عنه ـ أنّه روی عن أُمّ سلمة زوجة النبيّ’: أنّ هذه الآية نزلت في بيتها قالت: وأنا جالسة عند الباب، فقلتُ: يارسول الله، ألست من أهلٍ البيت؟
فقال: «إنّكِ إلی خير، إنّك من أزواج رسول الله». قالت: وفي البيت رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين^ فجللهم بكساء، وقال: «اللهمَ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرّهم تطهيراً»، وروي نحو هذا في أكثر كتبهم بطرق متعددة، وغيرها يُوجب التطويل، وإنّ دلالة هذه الآية علی عصمتهم ظاهرة لتفسير عامّة المحققين والمفسِّرين (الرجس) في الآية بالذنب، ويُراد من (التطهير) الطهارة من السوء والعيب والقبائح.
والظاهر من سياق الآية والأحاديث التعميم لجميع القبائح والأرجاس، والإرادة الواردة في الآية في قوله تعالی ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾، يراد منها الإرادة التكوينية، بمعنی أنّ الله تبارك وتعالی أذهب عنهم الرجس تكويناً في تكوينهم^، لا أنّ المقصود هو الإرادة التشريعية، بمعنی يجب عليهم أن يُطهّروا أنفسهم؛ وذلك لأنّ هذا الوجوب لا ينحصر بأهل بيت النبيّ’ لوضوح أنّ كلّ إنسان مكلَّف بتطهير نفسه، وأنّ المطهِّر والمزكِّي لنفسه هو المفلح حقيقةً وواقعاً. وأمّا الإرادة التكوينية فهي التي لا تتخلّف عنهم؛ لأنّها خُلقت في تكوينهم بخلاف الإرادة التشريعية، فقد يريد الله تبارك وتعالی التطهير بالإرادة التشريعية، لكن ما أكثر الذين لم يمتثلوا لأوامر الله تبارك وتعالی.
إذن، فعصمتهم ثابتة، ومتی ماثبتت عصمتهم لا يصحّ منهم الكذب؛ لأنَّ المعصوم لا تصدر منه المعصية، والكذب معصية، بل من أكبر المعاصي، ومن المعلوم أنّهم^ قد ادّعوا الإمامة فادّعاؤهم هذا لا بدّ وأن يكون صدقاً وحقّاً، وعليه فهم معصومون من الرّجس ومطهّرون من الدنس، وهم الأئمّة الهادون المهديون[613].
وقد يُقال: إنّ الإرادة التكوينية توجبُ أن يكون ذلك [أي إذهاب الرجس عنهم] جبراً.
والجواب: إنّ المعصومين^ لهم أهلية اكتسابية عن طريق أعمالهم، ولهم لياقة ذاتية ماهوية لهم من قِبل الله تبارك وتعالی، يستطيعون من خلالها أن يكونوا أُسوةً للناس.
وبتعبير آخر: إنّ المعصومين ـ ونتيجة للرعاية الإلهية وأعمالهم الطاهرة ـ لا يقدمون علی المعصية مع امتلاكهم القدرة والاختيار في إتيانها تماماً، كما أنّنا لا نری عاقلاً يرفع جمرةً من النار ويضعُها في فمه مع أنّه غير مُجبَر ولا مُكره علی الامتناع عن هذا العمل، فهذه الحالة تنبعث من أعماق وجود الإنسان نتيجة المعلومات والاطّلاع والمبادىء الفطرية والطبيعية، من دون أن يكون في الأمر جبر وإكراه[614].
ثُمَّ إنّ هذه الآية بالرغم من أنّها وردت ضمن الآيات المتعلقة بنساء النبيّ’، إلّا أنّ تغيير سياقها ـ حيث تبدّل ضمير الجمع المؤنث إلی ضمير الجمع المذكرـ دليل علی أنّ هذه الآية مختصّة بالنبيّ الأكرم’ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين^، والذاهبون إلى عدم اختصاصها بهم^ اعتقدوا أنّ لها معنیً واسعاً يشمل هؤلاء العظام مع نساء النبيّ’ ولم يقصروها علی نساء النبيّ’ فحسب. إلّا أنّ الروايات الكثيرة التي بين أيدينا هي التي تبيِّن لنا اختصاص هذه الآية بأهل بيت النبيّ الخاصّين، ولا تشمل نساءه ولاتشمل حتّی أقارب النبيّ’ الذين كانوا في مسمع ومرأی من الرسول الأعظم’، إلّا أنّ الآية لا تشملهم، وهناك روايات عديدة قد تصل إلی حدّ التواتر ذُكرت في مصادر المسلمين قاطبةً في أنّ الآية خاصّة بالنبيّ الأكرم’ وعلي وفاطمة والحسن والحسين ^.
فقد روی الثعلبي عن عائشة أنّها عندما سُئلت عن حرب الجمل وتدخّلها في تلك الحرب المدّمرة الطاحنة، قالت بأسفٍ: كان ذلك قضاء الله، وعندما سُئلت عن عليّ × قالت: تسأليني عن أحبّ النّاس كان إلی رسول الله’، وزوج أحبّ النّاس كان إلی رسول الله’، لقد رأيتُ عليّاً وفاطمة وحسناً وحُسيناً^ وجمع رسول الله’ بثوب عليهم، ثُمَّ قال « اللهمَ هؤلاء أهل بيتي وحامَّتي، فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً» قالت: فقلتُ: يارسول الله أنا من أهلك! قال: «تنحـّي فإنّك إلی خير».
وهنا سؤال يُلفت النظر وهو: ماهو الهدف من جمعهم تحت الكساء؟ والجواب هو: أنّ النبيّ’ كان يُريد أن يُحدّد هؤلاء ويعرّفهم تماماً، ويقول: إنّ الآية أعلاه في حقّ هؤلاء خاصّة؛ لئلا يری أحدٌ أو يظنَّ ظانٌّ أنَّ المخاطَب في هذه الآية كلّ مَن تربطه بالنبيِّ’ قرابة، وكلّ مَن يُعدّ جُزءاً من أهله، حتّی جاء في بعض الروايات أنّ النبيّ’ بقي ستّة أشهر بعد نزول هذه الآية يُنادي عند مروره من جنب بيت فاطمة ‘ وهو ذاهب إلی صلاة الصبح: «الصلاة يا أهل البيت، إنما يُريد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً». فإنّ تكرار هذا الأمر ستّة أشهر، أوأكثر من ذلك بصورة مستمرة إنّما هو لبيان هذه المسألة تماماً وإتماماً للحجَّة، كما هو الحال في وضعهم تحت الكساء؛ حتّی لا يبقی مجال للشكّ لدی أيّ شخص بأنّ هذه الآية نزلت في شأن هؤلاء النفر فقط، خاصّة وأنّ الدار هذه هي الوحيدة التي بقي بابُها مفتوحاً إلی داخل المسجد بعد أن أمر الله نبيه بأن تـُغلَّق جميع أبواب بيوت الآخرين، هي دار فاطمة‘، ولا شكّ أنّ جماعة من النّاس كانوا يسمعون ذلك القول من النبيّ’ حين الصلاة[615].
ومع هذا كلّه اعتدوا علی أهل بيت الوحي والعصمة والطهارة بعدما فارق النبيّ’ الدنيا، فجرت عليهم المصائب واحدة تلو الأُخری، هجموا علی تلك الدار التي كان يوصي بها النبيّ وأحرقوها إلی أن اعتدوا علی مَن فيها.. ومَن فيها ؟! فيها عليّ المرتضی، فيها فاطمة الزهراء، فيها الحسنان، هؤلاء بعدما فقدوا تلك الشمعة التي كانت تضيء لهم دارهم، في مثل هذه الليلة دار أمير المؤمنين× ـ وهي خالية من فاطمة الزهراء‘ ـ في الكوفة تضجّ بالعويل والبكاء، أوصی أمير المؤمنين × أولاده وشيعته بوصايا عديدة، إلی أن اشتدّ عليّه الألم، وتزايد ولوج السّم في جسده الشريف، حتّی نُظر إلی قدميه وقد احمرّتا فكبُر على أهل بيته ذلك، ويئسوا منه، ثُمَّ أصبح ثقيلاً، فدخل النّاسُ، أمرَهم ببعض الأوامر، ونهاهم عن بعض المناهي.
ثُمَّ عُرض عليه الأكل والشرب فأبی أن يأكل أو يشرب، فنظرنا ـ يقول مُحمّد بن الحنفية ـ إلی شفتيه وهما يختلجان بذكر الله، وجعل جبينه يرشح عرقاً وهو يمسحه.
ثُمَّ نادی أولاده صغيراً وكبيراً بأسمائهم، وجعل يُودّعهم واحداً واحداً، وهويقول: «الله خليفتي عليكم أستودعكم الله» ثُمَّ نادی أبا مُحمّد الحسن× وقال: «أوصيك بأبي عبد الله خيراً، فأنتما مني وأنا منكم».
ثُمَّ قال: «وعليكم السلام يارُسل ربّي، لمثل هذا فليعمل العاملون». وما زال يشهد الشهادتين، ثُمَّ استقبل القبلة وغمّض عينيه، ومدّد رجليه، وأسبل يديه، ثُمَّ قضی نحبه، فعند ذلك صرخت زينب (أم كُلثوم) وجميع نسائه وعياله، فعلم أهل الكوفة أنّ أمير المؤمنين× قضی نحبه، فأقبل الرجال والنساء أفواجاً، وصاحوا صيحةً عظيمةً، ارتجّت الكوفة بأهلها، وكثر البكاء والنحيب، تغيّر الأُفق وارتجّت الأرض، وسمع النّاس جلبةً وتسبيحاً وبكاءً في السماء، فعلموا أنّها أصوات الملائكة، وصار ذلك اليوم كيوم مات فيه الرسول[616].
وكأنّي بزينب‘ تتّجه إلی المدينة:
|
يجدّي لوتجي والوالده اوياك اوجيب الوالده الكسـروا ضلعها |
حملوا أمير المؤمنين× إلی مثواه الأخير ـ بأبي هو وأُمّي ـ هذا وزينب تنظر إلی ذلك الموقف العظيم وكأنّي بها:
|
مدري اشلون شالوا صعب المراس حسـن واحسين ومحمّد اوعبّاس |
***
|
يرمـي حشاها جَمْرَه من فيها[617] تدْعُو فتحـترقُ القلوب كأنـّما |
المحاضرة الخامسة والثلاثون: فضائل أهل البيت ^
|
مَن مُـبلغٌ عنّي الزمانَ عتابا |
عــتبي عــلی الأعــتاب فيها محسـنٌ
مُــلقــیً ومــا انهالت عـليه تُــرابــا[618]
***
|
يا باب فاطـم أُمّ الأطياب |
صـــدرها لعد گلـــب النبيّ صــاب
(أبوذية)
|
ذهيل اومابگتلي أفكار يلباب |
|
|
|
يوم العصـروا الزهره الزچيه |
***
قال رسول الله’ لأبي ذرّ&: «واعلمْ يا أبا ذرّ، أنَّ الله} جعل أهلَ بيتي في أُمّتي كسفينةِ نوح، مَن رَكِبَها نجا، ومَن رَغِبَ عنها غَرِقَ، ومثل بابِ حطّة في بني إسرائيل، مَن دخله كان آمناً»[619].
وصية النبيّ الأكرم’ رواها الشيخ أبو عليّ الطبرسي& في كتاب مكارم الأخلاق مسنداً[620]، ورواها أيضاً العالم الكامل الشيخ ورّام بن أبي فراس في مجموعته الأخلاقية المسمّاة (مجموعة ورّام) أو (تنبيه الخواطر ونزهة النواظر)[621]، ووردت مقاطع منها في طيّات بعض الكتب المطوّلة والمختصرة[622]، وعُلّقت عليها عدّة تعليقات، وشُرِحت بأفضل ماشُرحت به وبقلم خبير نحرير ألا وهو حبر الشيعة العلّامة الشيخ المجلسي&، صاحب الموسوعة القيـّمة بحار الأنوار، وطُبعت ـ بعد ترجمتها من الفارسية إلی العربية ـ بمجلدين[623].
يقول الراوي: دخلت علی أبي ذرّ جُندُب بن جُنادةE، فحدّثني أبو ذرّ قال: دخلتُ ذات يوم في صدر نهاره علی رسول الله’ في مسجده، فلم أرَ في المسجد أحداً من النّاس إلّارسول الله وعلي إلی جانبه، فاغتنمتُ خلوة المسجد، فقلتُ: يا رسول الله، بأبي أنت واُمّي، أوصني بوصية ينفعني الله بها. فقال: «نعم وأكرم بكَ يا أبا ذرّ، أنت منّا أهل البيت، وإنّي موصيك بوصية فاحفظها، فإنّها وصية جامعة لطرق الخير وسُبُله، فإنّك إن حفظتها كان لك بها كفلان...». وبدأ النبيّ الأعظم’، وأول ما بدأ به ـ بأبي هو وأُمّي ـ أن أوصی أبا ذرّ بالعبودية، قال له: «يا أبا ذّر، اعبد الله كأنّك تراه، فإن كنت لا تراه فإنّه يراك».
ثمَّ بدأ بذكر وصايا عديدة في فضل التوحيد والصلاة وأُمور أُخری، إلی أن يصل الدور ليوصي النبيّ الأعظم’ أبا ذرّ بالتمّسك بأهل البيت^ فقال’ لأبي ذرّ الغفاري&: «إنّ الله} جعل أهل بيتي في أُمّتي كسفينة نوح، مَن ركبها نجا، ومَن رغب عنها غرق»، هذا هو المقطع الأول من الوصية.
والمقطع الثاني: «ومثل باب حطّة في بني إسرائيل، مَن دخله كان آمناً».
أمّا المقطع الأول: فشبّه النبيّ الأكرم’ أهل بيته بسفينة نوح، فما هو الوجه في ذلك التشبيه، وما هي العلاقة بين أهل البيت^ وسفينة نوح (علی نبينا وآله وعليه السلام)؟
الجواب: إنَّ العلاقة بين أهل بيت العصمة والطهارة^ وسفينة نوح× وثيقة للغاية؛ إذ الطوفان المستوعب لجميع سطح الأرض لا يفرق بينه وبين الطوفان العقائدي الخاطئ، والنجاة غير موقوفة علی سفينة من الخشب والحديد، والخلاص من كلّ طُوفان بحسبه، فالطُوفان الذي حصل بالماء يُمكن النجاة منه بالركوب في سفينة من خشب وحديد، وأمّا الخلاص من العقاب الأُخروي والخلاص من الضلال، بل النجاة الحقيقية لا تتحقق إلّا بالركوب في سفينة النجاة، فما أحسن أن تكون هذه السفينة ديناً يُقوّم السلوك! ويهب الحياة الطيبة، ويُقاوم الأمواج والأفكار الانحرافية، ويُوصل أتباعه إلی ساحل النجاة، وعلی هذا الأساس وردت روايات كثيرة عن النبيّ’ في مصادر المسلمين تعبّر عن أهل بيته ـ وهم الأئمّة الطاهرون وحملة الإسلام ـ بأنّهم (سفينة النجاة).
يقول حنش بن المغيرة: وأبو ذرّ آخذ بحلقة باب الكعبة، وهويقول: أنا أبو ذرّ الغفاري، مَن لم يعرفني فأنا جُندُب صاحب رسول الله’ سمعتُ رسول الله’ يقول: «مَثل أهل بيتي مِثلَ سفينة نوح مَن ركبها نجا»، وفي الوصية التي افتتحنا بها المحاضرة: (ومَن رغِبَ عنها غرق). فهذا الحديث الشريف عن النبيّ’ يُبيّن بصراحة: أنّه حين يطغی الطوفان الفكري والعقائدي والاجتماعي في المجتمع الإسلامي، فإنّ طريق النجاة الوحيد هو الالتجاء إلی مذهب أهل البيت^ دون المذاهب التي اصطنعتها السلطات التي لا علاقة لها بأهل البيت^ لا من قريب ولا من بعيد[624].
فسفينة نوح لم تكن سفينة عادية، ولم تنتهِ بسهولة مع وسائل ذلك الزمان وآلاته؛ إذ كانت سفينة كبيرة تحمل بالإضافة إلی المؤمنين الصّادقين زوجين اثنين من كلّ نوع من الحيوانات، وتحمل متاعاً وطعاماً كثيراً، يكفي للمدّة التي يعيشها المؤمنون والحيوانات في السفينة حال الطوفان، ومثل هذه السفينة بهذا الحجم وقدرة الاستيعاب لم يسبق لها مثيل في ذلك الزمان، فهذه السفينة ستجري في بحر بسعة العالم، وينبغي أن تمر سالمة عبر أمواجٍ كالجبال فلا تتحطّم بها[625].
وهكذا أهل البيت^ فسفينتهم واسعة جدّاً، وستجري إلی يوم البعث والنشور في بحر هو العالم، ولا بُدّ أن تبقی سالمةً مهما كلّف الأمر؛ لأنّ الله تبارك وتعالی متمّ نوره ولوكره الكافرون والمعاندون والمنحرفون وجميع تيارات العالم، بل أكثر من ذلك أنّ سفينة نوح، النجاةُ فيها نجاةٌ من الموت وسفينة أهل البيت^ النجاة فيها من الموت الروحي والعقائدي إلی الحياة الخالدة الأبدّية، فهم^ كسفينة نوح من جهة النجاة، إلّا أنّ هناك فرقاً شاسعاً بين النجاتين وبين السفينتين.
ومن هنا فيمكن تلخيص وجه الشبه بين سفينة نوح وبين سفينة نجاة أهل البيت^ بأُمور:
الأول: إنّ نبيّ الله نوحاً (علی نبينا وآله وعليه السلام) كان ـ عندما يصنع السفينة ـ موضع استهزاء من القوم، والسخرية به وبأصحابه، وذلك ما يُشير إليه قوله تعالی: ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾[626]، وكذا في سفينة نجاة أهل البيت^، ففي الزمان الغابر إلی يومنا هذا يستهزئ مَن ليس من شيعتهم بهم وبشيعتهم، فهذا وجه شبه بين سفينة نوح (علی نبينا وآله وعليه السلام) وسفينة أهل البيت^.
الثاني: التهديد بالعذاب والسخط الإلهي لكلّ مَن لم يركب سفينة نوح، وهكذا التهديد بالعذاب والسخط الإلهي لكلّ مَن لم يعتقد بسفينة أهل البيت^، ولم يركب معهم ويسير علی نهجهم وطريقتهم، فكما أنّ الله تبارك وتعالی ابتلی المعاندين الذين لم يركبوا مع نوح× في سفينته بالطوفان، فكذلك سوف يُعذّب الله تبارك وتعالی المعاندين الذين لم يهتدوا بهدی أهل البيت^.
الثالث: أنَّ سفينة نوح× جرت فيهم في موجٍ شبّههه الباري بأنّه كالجبال لعظمته، قال تعالی: ﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ﴾[627].
وكذا الاعتصام والركوب في سفينة أهل البيت^، فهي تجري في أمواج كالجبال من الزخارف والاعتقادات الباطلة إلی ما شابه، ذلك فلا يستغربنَّ أحدٌ المهالك والمزالق التي يتعرّض إليها، وهو موالٍ لأهل بيت العصمة والطهارة.
الرابع: إنَّ مَن لم يركب في سفينة نوح ـ كابنه مثلاً وغيره ـ لا ينفعه لاجبلٌ ولا شيء آخر، فمصيره إلی الهلاك والعذاب الأخروي حتّی ولوكان من ذرّية نفس صاحب الرسالة والدعوة.
قال تعالی ـ على لسان ابن نوح× عندما قال له: ﴿يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا﴾[628]ـ : ﴿ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾، قال نوح×: ﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾[629].
وهكذا مَن لم يتمّسك بأهل البيت^ ولم يركب سفينتهم، لا تنفعه جبال رضوی، ولا عقائد أهل نجدٍ، أو غير ذلك، فالنجاة من الطوفان بالركوب في سفينة نوح×، والنجاة من الضلال في الدنيا والعذاب في الآخرة في ركوب سفينة أهل البيت^.
الخامس: إنَّ الشفاعة لا تنفع العاصين الذين لم يركبوا في سفينة نجاة نوح× ولوكان من ذرّية الداعي والمرسل، وإنّما الشفاعة تنفع العاصين الذين تمسّكوا بنوح وركبوا في سفينته، فهم حيث لم يكونوا معصومين كانت الشفاعة لهم ولأمثالهم من المؤمنين العاصين ـ إن كانوا قد عصوا ـ وأمّا أمثال ابن نوح نفسه فلا تنفعه الشفاعة؛ لأنّه لم يتمسّك بأبيه×.
قال تعالی: ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾[630].
وهناك تأمّلات أُخری تركناها للاختصار.
هذا كلّه في المقطع الأول من الوصية، وهو تشبيه أهل البيت^ بسفينة نوح×.
وأمّا المقطع الثاني من الوصية: وهو التشبيه بكونهم^ كَـ(باب حطّة) في بني إسرائيل، فقد أشار إليه القرآن الكريم في سورة البقرة، حيث قال تعالی: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ﴾[631]، وفي الرواية معنی حطّة أي: حطّ عنّا. أي: اغفر لنا[632]. ولا نطيل في هذا المقطع للتشابه بينه وبين المقطع الأول.
ووجه التشابه هو: إنَّ النجاة كلّ النجاة في التمسّك بأهل البيت^، فبنو إسرائيل كانت معاصيهم المتراكمة قد ازدادت فأرادوا تكفيرها، وذلك بعد التيه الذي امتدّ بهم مايقارب أربعين سنة، فأمرهم الله أن يدخلوا باب قرية أريحا، ويقولوا: اللهمَّ اغفر لنا، وحطّ عنا ذنوبنا. فدخل بعضهم من غير هذا الباب، وقال بعضٌ غير هذا القول، فقالوا: حنطة بدلاً عن حِطّة، فخالفوا فابتلاهم الله تعالی بالطاعون.
ثُمَّ إنّ هذين التشبيهين البليغين قد تواترا في أحاديث المسلمين، وهذا يدلّ علی وجوب الانقياد والتسليم لأهل البيت^ في كلّ شيء وعدم مخالفتهم، ولكن ابتُلي أهل البيت^ بالنّاس.
ومن هنا روي بسند معتبر عن الإمام الصّادق× أنّه قال: «بلية النّاس عظيمة، إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا»[633] فبابُ حِطّة بني إسرائيل هو باب قرية أريحا، وأمّا باب حطّة المسلمين فهو أهل البيت^.
روي عن أبي جعفر الباقر× أنّه قال: «نحن باب حطّتكم»[634]، هذا ما سمعته من فضائلهم^ وّهم باب حطّة ولا بدّ وأن يأتيهم كلّ إنسان ليدخل إليهم، ولكن القوم خلاف ذلك، فبدل أن يدخلوا باب أهل البيت^؛ ليحطـّوا ذنوبهم جاؤوا بالحطب ووضعوه علی باب دار عليّ وفاطمة، وهي قاعدةٌ خلف الباب قد نَحَلَ جسمها في وفاة رسول الله’ وهي مُعصّبة الرأس، فأقبل عُمر حتّی ضرب الباب، ثُمَّ نادی يا بن أبي طالب افتح الباب. فقالت فاطمة‘: «يا عُمر، ما لنا ولك لا تدعُنا وما نحن فيه؟!» قال: افتحي الباب وإلّا أحرقناه عليكم. فقالت: «يا عُمر، أما تتقي الله}، تدخل عليّ بيتي وتهجم علی داري؟!» فأبی أن ينصرف، ثُمَّ دعا عُمر بالنار فأضرمها في الباب، فأحرق الباب، ثُمَّ دفعه فاستقبلته فاطمة وصاحت: «يا أبتاه يا رسول الله»، فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت، فرفع السوط فضرب به ذراعها[635]. رحم الله الشيخ الأصفهاني حيث قال في الأنوار القدسية:
|
أتُضـرَمُ النّارُ بباب دارها |
لكنّ الأدهی من هذا كلّه والأصعب، والأمرَّ علی قلب كل غيورٍ قوله& أيضاً:
|
لكنّ كسـر الضلع ليـس ينجبر |
فاستعبرت باكية من شدّة ألمها وعِظم اهتظامها:
|
عدمَن أشتچي همّي |
(بحراني)
ياليت عينك شاهدتني وشافت اشصار
يا والدي امن اختارك الواحد القهّار
هجموا اعليَّ ونبتوا بالصدر مسمار
واسياط قنفذ اثَّرت بمتوني ارسُوم
|
بنتُ مَن؟ أمُّ مَن؟ حـليلةُ مَن |
المحاضرة السادسة والثلاثون: الاصطفاء
|
إنْ قيلَ حوّا قلتُ فاطمُ فخـرُها |
(موشّح)
يافارس بدر وحنين وبيوم الحرب فتـّاك
تصبر يا عليّ چندوب صبرك عجّب الأملاك
صبرك عجّب المخلوگ وأملاك السـمه كلها
وامصيبتك ياكرّار ما من نبي اليحملها
من جاك الرجـس للدار اونيته ابنار يشعلها
ما هابك يبو الحسنين وانته محّد اليدناك
من يدناك يابو احسـين وأنت الطوِّعيت الجن
لاچن العجب تصبر اوتسمع بالزچيه إتوِّن
بين الباب والحايط عصـرها وأسگطت محسن
اورضّ اضلوعها الطاغي اوروّعها ولا راعاك
وكأنّي بها:
|
تصـيح إبصوت يافضّه تعالي |
***
قال تعالی ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾[639].
الاصطفاء في اللغة هو: أخذ صفوة الشيء وتخليصه ممّا يُكدِّرهُ، فهو قريبٌ من معنی الاختيار[640].
تقول الآية: إنَّ الله اختار آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عِمران من بين النّاس جميعاً، وهذا الاختيار قد يكون اختياراً تكوينيّاً، وقد يكون اختياراً تشريعياً، والاختيار التكويني بمعنی أنّ الله قد خلق هؤلاء مُنـذُ البدء خلقاً متميِّزاً وإن لم يكن في هذا الامتياز ما يجبرهم علی اختيار طريق الحقّ، بل إنّهم بملء اختيارهم وحرّية إرادتهم اختاروه، غير أنَّ ذلك التميّز أعدّهم للقيام بهداية البشر، ثُمَّ علی أثر إطاعتهم أوامر الله والتقوی والسعي في سبيل هداية النّاس نالوا نوعاً من التميّز الاكتسابي الذي امتزج بتميّزهم الذاتي فكانوا من المصطَفين.
وتـُشير الآية أيضاً إلی أنَّ هؤلاء المصطَفين كانوا من حيث الإسلام والطهارة والتقوی والجهاد في سبيل هداية البشر متشابهين، كمثل نُسَخٍ عدّة من كتاب واحد يقتبس كلٌّ من الآخر؛ ولذا قالت الآية بعضها من بعض[641].
وهنا يُطرح سؤال وهو: ما هو الوجه في اصطفاء مَن ذُكر في الآية وهم: ﴿ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ﴾ أوَ ليس الأنبياء جميعهم قد اصطفاهم الله تبارك وتعالی، فما هو الوجه؟ أو قل: ما هي العلَّة في ذكر هذه الثلَّة العظيمة من هؤلاء ^؟
ويمكن الجواب عن هذا السؤال بأن يُقال: إنَّ الآية ليست بصدد ذكر جميع الذين إصطفاهم الله، بل تُعدّد بعضاً منهم، فإذا لم يكن بعض الأنبياء من بين هؤلاء، فلا يعني ذلك أنّهم ليسوا مصطفين.
ثُمَّ إنَّ (آل ابراهيم) يشمل موسی بن عمران ونبيّ الإسلام والمصطفين من أهله أيضاً؛ لأنّهم جميعاً من (آل ابراهيم)، وفي نفس الوقت لا يعني ذلك اصطفاء آل إبراهيم بجميعهم؛ إذ يُحتمل أن يكون بينهم حتّی من الكفار، إنّما المقصود هو (بعض) من آل إبراهيم وآل عمران[642].
ثمَّ إنّ هؤلاء قد تميّز كلُّ منهم بخصوصيات لم يوجد بعضها في سائر الأنبياء^، فأمّا آدم فقد اصطُفي علی العالمين بأنّه أوّل خليفة من هذا النوع الإنساني جعله الله في الأرض، قال تعالی: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾[643]، وأوّل مَن فتح به باب التوبة، قال تعالی: ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾[644] وأوّل مَن شُرِّع له الدين، قال تعالی: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾[645]، فهذه أُمورٌ لا يُشاركه فيها غيره، ويالها من منقبة له×!
وأمّا نوح× فهو أوّل الخمسة أُولي العزم، صاحب الكتاب والشريعة، كما أنّه الأب الثاني لهذا النوع، وقد سلّم الله تعالی عليه في العالمين،إذ قال تعالی: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾[646].
ثمَّ ذكر سبحانه وتعالی آل ابراهيم وآل عمران من هؤلاء المُصطفين، والآل خاصّة الشيء، وأمّا آل إبراهيم، فالظاهر منه أنّهم الطيّبون من ذرّيته كإسحاق وإسرائيل والأنبياء من بني إسرائيل وإسماعيل والطاهرين من ذرّيته ، وسيّدهم مُحمّد’ والملحقون بهم في مقامات الولاية، إلّا أنّ ذكر آل عمران مع آل إبراهيم يدّل علی أنّه لم يستعمل علی تلك السعة.
فالمراد بآل إبراهيم هم الطاهرون من ذرّيته من طريق إسماعيل، والآية ليست في مقام الحصر، فلا تنافي بين عدم تعرُّضها لاصطفاء نفس إبراهيم واصطفاء موسی وسائر الأنبياء الطاهرين من ذرّيته من طريق إسحاق، وبين ما تـُثبتها آيات كثيرة من مناقبهم وسمو شأنّهم وعلوّ مقامهم؛ فإنّ إثبات الشيء لا يستلزم نفي ما عداه.
وأمّا آل عمران، فالظاهر أنَّ المراد بعمران أبو مريم، كما يُشعر به تعقيب هاتين الآيتين بالآيات التي تذكر قصّة امرأة عمران، ومريم ابنة عمران، وقد تكرّر ذكر عمران أبي مريم باسمه في القرآن الكريم، ولم يرد ذِكْر عمران أبي موسی حتّی في موضع واحد يتعيّن فيه كونه هو المراد بعينه، وهذا يؤيّد كون المراد بعمران في الآية أبا مريم‘؛ وعلی هذا فالمراد بآل عمران هو مريم وعيسی÷، أو هما وزوجة عمران.
﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾ فيه دلالة علی أنّ كلّ بعض فرعٍ منها يبتدي وينتهي من البعض الآخر وإليه، ولازمه كون المجموع تشابه الأجزاء لا يفترق البعض من البعض في أوصافه وحالاته، وإذا كان الكلام في اصطفائهم أفاد ذلك أنّهم ذرّية لا يفترقون في صفات الفضيلة التي اصطفاهم الله لأجلها علی العالمين، إذ لا جُزاف ولا لـَعِب في الأفعال الإلهية، ومنها الاصطفاء الذي هو منشأ خيرات هامّة في العالم.
ثمَّ قالت الآية: ﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، أي سميع بأقوالهم الدالّة علی باطن ضمائرهم، عليم بباطن ضمائرهم وما في قلوبهم؛ فالجملة بمنزلة التعليل لاصطفائهم، كما أنّ قوله: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾، بمنزلة التعليل لشمول موهبة الاصطفاء لهؤلاء الجماعة.
فالمحصّل من الكلام: إنّ الله اصطفی هؤلاء علی العالمين، وإنّما سری الاصطفاء إلی جميعهم؛ لأنّهم ذرّية متشابهة الأفراد، بعضهم يرجع إلی البعض في تسليم القلوب وثبات القول بالحقّ، وإنّما أنعم عليهم بالاصطفاء علی العالمين؛ لأنّه سميع عليم، يسمع أقوالهم و يعلم ما في قلوبهم[647].
ولعلَّ معنی (أنّ الله سميع عليم): أنّه تعالی سميع عليم بأقوال النّاس، فيصطفي مَن له المصلحة في اصطفائه[648].
ثُمَّ إنّه ورد في الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة^ عن النبيّ الأعظم’ أنّه قال في وصية له لأمير المؤمنين×: «يا عليّ، إنّ الله} أشرف علی الدنيا فاختارني منها علی رجال العالمين، ثُمَّ اطّلع الثانية فاختارك علی رجال العالمين بعدي، ثُمَّ اطّلع الثالثة فاختار الأئمّة من ولدِك علی رجال العالمين بعدك، ثُمَّ اطّلع الرابعة فاختار فاطمة علی نساء العالمين»[649].
هؤلاء هم ذرية النبيّ’، وبهم يُدفع البلاء ويكشف الكرب.
نـَقل بعض العلماء عن العالم العامل الثقة الجليل آية الله الشيخ العلّامة المعروف بـ(آقاي علّامة) بمدينة بم الإيرانية، قال: جاء إلی مدينة يزد جماعة من علماء النصاری ـ وكان ذلك أيام حُكم رضا شاه ـ ليسألوا العلماء والخطباء عن بعض مسائل الإسلام، وكان الغرض الأصلي من ذلك هو إلقاء الشكّ والشبهة في قلوب النّاس؛ ليبتعدوا عن الإسلام وعلماء الدين، فاختاروا إحدى الباحات العامّة لذلك، وتجمّع النّاس من مختلف الطبقات، واستمرت هذه الحال ثلاثة أيام قال الشيخ: وكنتُ غائباً فأُخبرتُ بالموضوع فحضرت، فقال لي بعض العلماء: إنَّ هؤلاء القوم الغرباء ألقوا الشكّ في قلوب النّاس، فانظر ماذا تصنع أنت؟
قال الشيخ: فتقدَّمتُ ـ بعد التوكّل علی الله تعالی ـ لأستمع إلی بعض أسئلتهم، فقال لي رئيسهم: أتؤمنون بالمسيح عيسی؟
قلتُ: نعم نؤمن به نبيّاً من الأنبياء، وهو الذي بشَّر بنبوةِ نبيّنا مُحمّد’ وبذلك صرّح القرآن.
فقال: أنتم تروون حديثاً عن نبيّكم وهو قوله: «علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل»، قلتُ: نعم.
فقال: إنَّ أنبياء بني إسرائيل يُحيون الموتی أتفعلون ذلك أنتم؟
قلتُ: إنَّ أنبياء بني إسرائيل لا يفعلون ذلك إلّا إذا توقف الاعتقاد بنبوتهم عليه، ويكون ذلك بإذن الله تعالی، ونحنُ نفعل ذلك بشرط أن تذهب وتأتينا من كلّ بلدٍ مسيحيٍّ بمندوب وتأتون إلی هنا، وهذه مقبرة المسلمين نحييها لكم بمَن فيها رجالاً ونساء صغاراً وكباراً.
قال الشيخ: نظرتُ إليهم وهم ينظر بعضهم بوجه بعضٍ في غاية الدهشة والتعجّب، ولم يجدوا سبيلاً غير قبول كلامي.
فقالوا ـ بعد المشاورة ـ: نذهبُ إلی الفاتيكان ونعرض عليهم الأمر، ثُمَّ انتهت الجلسة وخرجوا من ذلك المكان.
فانهال النّاس عليّ يُقبلون يدي، ويتشكّرون مني ويُباركون عملي، واجتمع العلماء فسألوني: كيف تستطيع أن تحيي الموتی؟
فقلتُ: إنّكم غفلتم عن شيء أساسي وهو وجود الإمام المهدي صاحب الزمان×، فإنَّ القوم إن جاؤوا إلی هنا فسأفرش عباءتي وسط الطريق وأصلي لربي ركعتين وأتوسّل بالحجّة المنتظر#، وهوالذي يأتي ويُحيي الموتی بقدرة الله} لا أنا وأمثالي، وشاع الخبر في كلّ مكانٍ.
يقول الشيخ: وبعد هذه القضية بمدةٍ قصيرةٍ وبينا أنا في البيت إذ طـُرق الباب، فذهبتُ بنفسي وفتحتُ الباب، وإذا برجلٍ ومعه امرأة طلب مني أن أسمح له بالدخول؛ لأنّه يُريدني لأمرٍ، فدخل، وعندما استقرّ به المجلس قال: أنا رجلٌ من الزردوشت ـ وهم فرقة يعبدون النار ـ ولستُ من المسلمين، وهذه المرأة زوجتي وقد سمعت بمحاججتك مع النصاری، وقد جئتُ أطلبُ منك أن تهديني إلی عملٍ أعمله لأُرزَق به مولوداً، فقد مضی علی زواجي عشرون عاماً وأنا من غير ذرّية، أتستطيع مساعدتي في ذلك؟ فقلتُ له: نعم، ولكن بشرط أن تنوي نيةً صادقة أنت وزوجتـُك الدخول في دين الإسلام، فقال: نعم أوافق علی هذا الشرط، وها أنا نويتُ وكذا قالت الزوجة.
قال الشيخ: فقلتُ له: اذهب إلی خراسان حيث المرقد المقدّس للإمام عليّ بن موسی الرضا×، ولا تدخل إلی داخل الحرم، ولكن اطلب حاجتك من خارج الحرم تـُقضی بإذن الله تعالی.
قال الشيخ: ذهبَ الرجل ومرّت مدّة طويلة كدت أن أنسی الموضوع، وإذا رجل يأتي ومعه زوجته وطرق الباب فعندما فتحتُ له الباب حيّاني بتحية الإسلام، فقال: السلام عليكم. فرددتُ عليه السلام، ودخل.
فقال: البشری يا شيخ، إنّ امرأتي حامل في شهرها الخامس، وأنا منذ الشهر الأول أصبحت مسلماً وكذلك زوجتي، وقد جئنا نُجدّد إسلامنا علی يديك وقد بقيتُ هذه الأشهر مأنوساً عند الإمام الرضا×، حتّی تحرّك الجنين في بطن أُمّه، ثُمَّ تشهّدا الشهادتين وأقرَّا بالأئمّة من آل مُحمّد’.
فقلتُ: الحمدُ لله علی قضاء حاجتك وإسلامك، ها أنت قد أصبحت من المسلمين، فسأختار لك إسماً جديداً وهو (عليّ) فقال: حُبّاً وكرامة.
وقلتُ: واخترتُ لجنينكم إسماً وهو (رضا)، وأمّا أنتِ أيتها المرأة المسلمة فأختار لك إسماً وهو (نجمة) باسم أُمِّ الإمام الرضا×، فقالت: ولكنّي أسمع الشيعة في مجالسهم ينوحون ويندبون ويُنادون: زهراء يا زهراء يا زهراء فأحببتُ هذا الاسم، وأرغبُ أن يكون لي هذا الاسم الشريف.
الله أكبر، اسم فاطمة في قلب هذه المرأة الطيبة، لكنّ القوم كانوا يعرفون مَن هي فاطمة؟ ومع هذا آذوها.
|
أيّها النّاس بابُ فاطمَ بأبي |
وكأنّي بها تخاطب أباها’:
(نصاري)
|
گومك يبويه مارعوني |
اوبــرّه المـــديــنـه طــلّــعــونــي
***
|
أدموا نواظرها ميراثها غصبوا[650] |
المحاضرة السابعة والثلاثون: الشُّكر
|
أيا راكباً مِهريةً شأتِ الصّبا |
ولذا لمّا سأل أبو حمزةالإمامَ زينَ العابدين× عن سبب حُزنه كأنّي بهِ يجيبه:
(موشّح)
|
اگبال عيني شفت گومي امصّـرعه |
***
قال تعالى: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾[652].
موضوع هذه الآية الشّريفة ـ كما هو واضح ـ هو الشكر، فما هي حقيقته وأقسامه، وكيف نشكر المنعم؟
قال الراغب: «الشُكر تصوّر النعمة وإظهارها، قيل: وهو مقلوب عن الكشر، أي: الكشف، ويضادُّه الكفر، وهو نسيان النعمة وسترها، ودابّة شكورة مظهرة بسمنة إسداء صاحبها إليها»[653].
ويبنغي الكلام في عدّة مقامات:
المقام الأوّل: أنواع الشكر
1ـ شُكرٌ بالقلب: وهو تصوّر النعمة، فعن أبي عبد الله الصادق× أنّه قال: «مَن أنعم الله عليه بنعمةٍ فعرفها بقلبه فقد أدّى شُكرها»[654].
2ـ شُكرٌ باللسان: وهو الثناء على المُنعم.
3ـ شُكرٌ بسائر الجوارح: وهو مكافاة النعمة بقدر استحقاقها، قال أميرُ المؤمنين×: «ما كان الله ليفتح على عبدٍ باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة»[655].
وفي الاحتجاج عن الإمام موسى بن جعفر× عن آبائه^ قال: «قال أميرُ المؤمنين×: ولقد قام رسولُ الله’ عشر سنين على أطرافِ أصابعه حتّى تورّمت قدماه واصّفرَّ وجُهه، يقوم الليلَ أجمع حتّى عُوتب في ذلك، فقال تعالى: ﴿طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ بل لتُسعد به [656].
المقام الثاني في محل الاستدراج:
الاستدراج وهو أنّ العبد كُلّما جدّدَ خطيئةً جدّد الله له نعمة وأنساه الاستغفار، وأن يأخذه قليلاً قليلاً ولا يباغته.
وأوّل ثمرةٍ من ثمرات الشُكر تظهر لمنع الاستدراج، ففي الكافي الشّريف عن عُمر بن يزيد، قال: قُلت لأبي عبد الله×: «إنّي سألتُ الله} أن يرزُقَني مالاً فرزقني، وإنّي سألتُ الله أن يرزقني ولداً فرزقني ولداً، وسألتُه أن يرزقني داراً فرزقني، وقد خفتُ أن يكون ذلك استدراجاً، فقال: أما والله مع الحمد فلا [657].
فالاستدراج إذن لا يحصل مع الشُكر والحمد لله تبارك وتعالى.
المقام الثالث: في أهمّ أقسام الشُّكر
من أهمّ أقسام الشُّكر هو الشكر لمَن أُجريت على يديه النعمة، حتّى عُدّ الشّاكر لله تعالى، ولم يشكُر مَن أُجريت النعمة على يديه من الّذين لم يشكروا النّعمة، كما في غير روايةٍ، منها:
عن أبي الصّلت الهَروي عن الإمام الرضا× عن آبائه عن أجداده عن رسول الله’ حيثُ قال’: «يُؤتى بعبدٍ يومَ القيامة فيُوقَف بين يديّ الله فَيأمرُ بهِ إلى النّار! فيقول: أيّ ربِّ، أمرتَ بي إلى النار وقد قرأتُ القُرآن، فيقول الله: أي عبدي، إنّي أنعمتُ عليك ولم تشكر نعمتي. فيقول: ربّي أنعمت عليَّ بكذا شكرتُك بكذا، وأنعمت عليَّ بكذا فشكرتك بكذا. فلا يزال يُحصي النّعم ويُعدّد الشُكر، فيقولُ الله تعالى: صدقتَ عبدي، إلّا أنَّك لم تَشْكُر مَن أَجريتُ لك نعمتي على يديه، وإنّي قد آليتُ على نفسي أن لا أقبلُ شُكرَ عبدٍ لنعمةٍ أنعمتُها عليه حتّى يَشكُرَ مَن ساقها من خلقي إليه[658].
المقام الرابع: كيفيّة شُكر المُنعم
إنَّ لشكران كُلِّ نعمةٍ أنعم بها الله تبارك وتعالى ـ سواء صارت وأُجريت على يد إنسان آخر أم لا ـ شروطاً ينبغي معرفتها:
الأول: أن يعرف نِعَمَه ولا ينسب إلى ذاته وصفاته ما لا يليقُ به، وكلّ ما قابل هذا المعنى فهو الكُفران، وقد ذمَّ الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات الكُفارَ لكفرانهم بالنعم، وإنكار وجود منعمهم، وجعل الشّريك له[659].
الثاني: أن يعلم هذهِ النعمة مِن قِبَلِ مَن جاءت؟ ولا ينسب نِعمَ الله إلى غيره.
الثالث: أن يُظهر تلك النعمة ويجري ثناءَ المنعم على اللّسان، كما رُوي بأسانيد معتبرة عن أبي عبد الله الصادق× أنَّه قال: «ما أنعم الله على عبدٍ بنعمةٍ صَغُرتْ أو كَبُرتْ فقال: الحمدُ لله، إلّا أدّى شُكرَها»[660].
الرابع: أن يُصرِفَ تلك النعمة فيما يُرضي المُنعم، وأن يُؤدّي الحقَّ الّذي جعله الله تعالى في تلك النعمة، فمثلاً: شكر نعمة اللسان التحدُّث بما أوجب الله تعالى والتحدّثَ عنه، وحفظه عن المُحرّمات والمكروهات.
وكذلك شكر العين والأُذن واليد والرِجْل وسائر الأعضاء والجوارح والقوى، وشكر المال صرفه فيما يرضي المنعم، وأداء ما أوجبه فيه، وشكر نعمة العلم بذله إلى طُلّابه والعمل به، ولا يجعله آلةً للباطل، وفي كلِّ هذا يُعوّضه الله وفقاً لما أوعده.
ومن جُملة شُكر المنعم التفكّر في نَعمِهِ والإقرار بأنّها لا تُحصى، ولو تفكّر شخصٌ في نعم الله الّتي تترتّب على أكلِ كُلِّ لُقمةِ خُبزٍ من طريقة تحصيلها إلى صيرورتها بهذهِ الهيئة القابلة للأكل وما يترتّب عليها بعد الأكل إلى صيرورتها جُزءاً في الجسم، لأذعن باستحالة عدّ نعم الله، بل لو تفكّر جيّداً لرأى أنّ كُلَّ نعمةٍ أنعمها الله تعالى إلى غيره تكون نعمةً له أيضاً؛ لأنّ الإنسان مدنّيٌ بالطّبع ومُحتاج إلى الآخرين؛ لأنَّ كلَّ نعمةٍ أُنعمت على كُلّ شخصٍ من لَدُن آدم× إلى زمان الشُكر، لها دخلٌ في وجودك وبقائك وكمالك.
فهذا هو التفكّر الممدوح والذي أمر به الأئمّة^، وله فوائد جمّه؛ لأنَّه يُوجب مزيدَ المعرفة بالمُنعم، ويعرّفُ عجزَ الإنسانِ ونقصَه واحتياجَه، فيكون باعثاً على العبادة ومانعاً عن المحرّمات، ويوجب الرضا بقضاء الله وعدم كفران النعمة، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾[661]، ورُوي عن الإمام الجواد × أنَّه قال: «دعا سلمانُ& أبا ذر إلى منزله، فقدّم إليه رغيفين، فأخذ أبو ذر الرغيفين يُقلّبهُما، فقال له سلمان: يا أبا ذر لأيِّ شيءٍ تُقلّبُ هذين الرغيفين؟ قال: خفتُ أن لا يكونا نضجين. فغضب سلمان من ذلك غضباً شديداً، ثُمَّ قالَ: ما أجرأكَ حيثُ تُقلّبُ هذين الرغيفين، فوالله، لقد عمل في هذا الخبز الماءُ الّذي تحت العرش، وعملت فيه الملائكة حتّى ألقوه إلى الريح، وعملت فيهِ الريح حتّى ألقته إلى السّحاب، وعمل فيه السحاب حتّى أمطره إلى الأرض، وعمل فيه الرّعد والملائكة حتّى وضعوه مواضِعَه، وعملت فيه الأرض والخشب والحديد والبهائم والنار والحطب والملح، وما لا أُحصيه أكثر، فكيف لك أن تقوم بهذا الشُّكر؟! فقال أبوذر: إلى الله أتوب، وأستغفرُ الله ممّا أحدثتُ، وإليك أعتذر ممّا كرهت»[662].
ولذا يكون الإنسان عاجزاً عن أداء الشُّكر لله تعالى.
أوحى الله تعالى إلى موسى×: «يا موسى، اشكرني حقَّ شُكري، فقال: ياربّ، كيف أشكُرك حقَّ شُكرِك؟ وليس من شُكرٍ أشكرُك بهِ إلّا وأنتَ أنعمتَ بهِ عَليَّ.
فقال: يا موسى، شكرتني حقَّ شُكري حِينَ عَلِمتَ أنَّ ذلك مِنَي»[663].
وقد ورد عن الإمام زين العابدين× في الصّحيفة المباركة السّجادية في دُعائه في الإعتراف بالتقصير عن تأدية الشكر قوله: «فأشْكَرُ عبادِك عاجزٌ عن شُكرِك»[664].
ويقول أيضاً في مُناجاة الشّاكرين: «فكيفَ لي بتحصيلِ الشُكر وشُكري إيّاك يفتقر إلى شُكرٍ، فكلّما قُلت: لكَ الحمد وجب عليّ لذلك أن أقول لك الحمدُ»[665].
وأيضاً كلّ معصية هي كفران لنعم غير مُتناهية من نعم الله تعالى، سواء في أصول الدّين أم في فروعه، مثلاً: أنّ وجود نبيّ آخر الزمان’ وبعثته من أعظم النعم الإلهيّة على العباد، فقد جعله الله تعالى وسيلة للسّعادة الأبديّة، وواسطةً للنّعم الدُنيويّة والأُخرويّة، وكذلك أوصياؤه^.
وشكر هذه النّعمة الإقرار بعظمتِهم وإطاعتِهم في الأوامر والنواهي، فإنكارهم أقبح مصاديق الكُفران بنعمة وجودِهم، وبعد الإقرار ففي كلّ ذنبٍ يكون كافراً لهذهِ النعمة العظيمة، والذنب لا بُدَّ أن يصدر من عضوٍ من الأعضاء، فيكون الكفر بنعمة ذلك العضو.
لكن للأسف لم يُعرف قدر النبيّ الأكرم’ وقدر أهل بيته^، ولم يُشكروا على النعمة الّتي أجراها الله تبارك وتعالى على أيديهم، وقدّموها إلى هذهِ الأُمّة، فجاءت الظلامات تترا على أهل بيت العصمة والطّهارة.
فعندما توفي النبيّ الأكرم’ بدأت تظهر قساوة القوم، وظلمهم أخذ ينتشر انتشار النار في الهشيم، فأوّل حقٍ اغتصبوه هو حقّ الولاية لأمير المؤمنين× الّذي ندب به القُرآن، ولهجت به السُنّة المطهرة، وعظّمه أهلُ البيت^.
ومن هُنا نجد أنَّ الحوار الصِدامي الّذي خاضته فاطمة الزهراء‘ ضد أبي بكر، وتحت لافتة (فدك) لم يكن من أجل (فدك)، وهي العزوفة المتقشّفة في كُلِّ مراحل حياتِها، وإنّما كانت تُحاول مجابهة الخلافة الّتي لم تعترف بها من جهةٍ، والدّفاع عن قُدسيتها كمعصومة.
وفي الجانب الآخر نجد أنَّ حرص أبي بكر على مُصادرة (فدك) لم يكن حرصاً على فدك بمقدار ما كان حرصاً على صرف الخلافة عن الإمامِ أمير المؤمنين×، كما كان لضرب العصمة بدليل مطالبة الزهراء‘ بكون فدك كانت لها نحلة من رسول الله| بالشهود، رغم أنَّ ذا اليد لا يُطالبُ بالشهود، ورغم أنَّ كُلَّ مَن عصمه الله بنصّ القُرآن لا يطالب بالشهود، فشاهده القرآن وكفى به شاهداً[666].
فعندما ألقت الحُجّة على القوم بخُطبتها الّتي بيّنت فيها ملخصاً كاملاً عن الشريعة الإسلامية، وما اشتملت عليه من المعارف الإلهيّة، رجعت بعد ذلك إلى الدار ، فلمّا استقرّت بها الحال، قالت لأمير المؤمنين×: «يا بن أبي طالب، إشتملت شَملة الجنين، وقعدت حجرة الظنين ويلاي في كلِّ شارق، مات العَمَدُ ووهَنَ العضُد! شكواي إلى أبي! وعدواي إلى ربِّي! اللهمَّ أنت أشدّ قوّة وحولاً، وأحدَّ بأساً وتنكيلاً».
فقال أميرُ المؤمنين×:«لا ويلَ عليكِ، الويل لشانئِكِ، نهنهي عن وجدكِ يا ابنة الصفوة وبقيّة النبوّة، فما وهنتُ عن ديني ولا أخطأتُ مقدوري، فإنّ كُنتِ تريدينَ البُلغة فرزقكِ مضمون، وكفيلُكِ مأمونَ، وما أعدَ لكِ خيرٌ ممّا قطع عنكِ، فاحتسبي الله. فقالت: حسبي الله. وأمسكت وجلست في دارها حزينةً باكيةً»[667]:
آه:
|
طبت دارها وظلّت عليلة |
***
|
ظلت توّن والونّه شجيه |
وكأنّي بها تقول: يا أبتاه جرحوا عيني وكسروا قلبي
(بحراني)
ظلّيت أسبح بالهظم والظلم والجور
من فارگت وجهك ووجهك مصدرالنور
وبعين مجروحه أعيش وضلع مكسور
من عصرت الباب الّذت بيها عن الگوم
يا ليت عينك شاهدتني وشافت الصّار
يا والدي من اختارك الواحد القهار
هجمو عليّ ونبتوا بالصدر مسمار
وسياط قنفذ سوّت بمتني الرسوم
لمَن تتوجه؟! لأبيها وقد صافح التُرابُ جبينَه!
عندها توجّهت لزوجها أمير المؤمنين×:
(تغريد الحزين)
|
عدمن أشتـكـي همّـي ويــاهو اليشـكّــيني |
فبنى لها أميرُ المؤمنين× بيتاً سمّاه بيتَ الأحزان، فقامت تأخذ بيد الحسن والحُسين÷ وتبكي عند قبر والدها، وتشكي ما جرى عليها بعد فراق والدها[668]، وكأنّي بها:
|
بويه الگوم بعدك لوّعوني |
***
|
والله مدلله بيام أبوها |
اجـوا للبـاب ويلـي واعصـروها
ذكر بعضُهم أنّ أسماء سألت الإمام أمير المؤمنين× عن شدّة بكائه على فاطمة‘؟ فقال: «عندما أوصتني فاطمة أن أُغسّلها من وراء الثياب، غسّلتُها فبينما أنا أُغسّلُها وإذا نظرت إلى ثيابها قد ارتفعت، ففتشت عن السبب فوجدتُ أحد أضلاعها مكسورة»[669].
الشاعر يتوجّه لأمير المؤمنين× يُخاطبُه يقول له: ضِلعٌ واحد هكذا أثّر بك وأخذ منك هذا المأخذ يا أمير المؤمنين! فكيف بك لو رأيتَ تلك الأضلاع المهشومة المكسورة والمرضوضة، وهي أضلاع سيد الشهداء أبي عبد الله؟!
آه:
|
ضلع واحد عليّ رخّص دموع العين وظل يجذب الحسرة ويصفج ايدين |
***
|
وبرضّ ذاك الضلع رُضّت أضلع |
المحاضرة الثامنة والثلاثون: معطيات آية القُربى
|
يا خليليَّ خبّرانِ بصدقٍ رُبّما يطلبُ النبيهُ انتباها |
***
(بحراني)
|
بنت النبي ماتت بعلّتها خفية |
(أبوذية)
|
أريد أگعد ونوحن بيك يابيت |
***
قال تعالى في محكم كتابه الكريم: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا﴾[671].
بعد ما رجع النبيّ’ إلى المدينة المنوّرة نزل جبرائيل من عند الرّب الجليل بالآية الكريمة، فانشغل فكرُ النبيِّ بذي القربى مَن هم؟ وما حقّهم؟ فنزل جبرائيل ثانياً عليه، وقال: «إنَّ الله سبحانه يأمرك أن تُعطي فدكاً لفاطمة‘، فطلب النبيُّ’ ابنته فاطمة‘ وقال: إنّ الله تعالى أمرني أن أدفعَ إليكِ فدكاً. فمنحها وتصرّفت هي فيها وأخذت حاصلها، فكانت تُنفقها على المساكين»[672].
والرويات الّتي في مصادرنا في تفسير هذه الآية فهي كثيرة، روى عدداً منها السّيد هاشم البحراني في تفسيره البُرهان في ذيل هذه الآية المباركة، وقد ذكر ما يقارب العشرين رواية وهي بهذا المضمون وإن اختلفت بالألفاظ، وفي بعضها الصّحيح من الروايات، وهو كافٍ لنا في تحقّق الواقعة[673].
وأمّا من طريق العامّة، فقد ذكر ذلك السّيوطي في الدّر المنثور[674] والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل[675] والمُتقي الهندي في كنز العُمّال[676]، والشّيخ سُليمان الحنفي في ينابيع المودة[677]، وغيرهم.
فكانت فدك في يد فاطمة‘، يعملُ عليها عُمّالُها، ويأتون بحاصلها في حياة النبيِّ’، وهي‘ كانت تتصرّف فيها كيفما شاءت، تُنفقُ على نفسِها وعيالِها وتتصدّق منها على الفقراء والمعوزين.
ولكن بعد وفاة رسول الله’ أرسل أبو بكر جماعةً فأخرجوا عُمّالَ فاطمة من فدك، وغصبوها وتصرّفوا فيها تصرفاً عدوانياً.
فعندما سُئل عن ذلك، قال: سمعنا النبي’ قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، ما تركناهُ صدقة»[678].
ولكن بغضّ النظر عن إسناد الحديث ومُعارضته لكتاب الله.
أولاً: هل يُصدّقُ إنسان بهذا الكلام، بعدما سمعتَ من هؤلاء بأنَّ فدكاً كانت نحلةً وهبةً من النبيِّ’، وهي استلمتها وتصرّفت فيها، فهي‘ كانت متصرِّفة في فدك حين أخذها أبو بكر، وما كانت إرثاً.
وثانياً: إنَّ الحديثَ الّذي استند إليه أبو بكر مردود وغير مقبول؛ لأنّه حديث موضوع، لوجود إشكالات فيه، فإنَّ واضع الحديث عندما وضعه قد غفل عن آيات المواريث الّتي جاءت في القُرآن الكريم، ولو كان يقول، مثلاً: «أنا لا أورّث» لأمكن لمحتملٍِ أن يحتمل ـ ولو احتمالاً غير معتدٍ به ـ أن هذا من مختصات النبي محمد’ دون سائر الأنبياء في مسألة وراثة الأموال التي ذُكرت فيها آيات عديدة في القرآن، أمّا على الصّيغة الأُولى فتكذيب أبي بكر وردّهِ أولى من نسبة ما يُخالف القُرآن إلى النبيِّ’.
ولذلك احتّجت فاطمة الزَّهراء‘ في خُطبتها الّتي نُقلت في كثير من كُتب المؤرّخين من العامّة والخاصّة، وممّن ذكرها ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة[679].
وجاء فيها: «ثُمَّ أنتم الآن تزعمون أن لا أرث لي، أفحكمُ الجاهليةِ تبغون؟ ومَن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. إيهاً معاشر المُسلمين أُبتَزُّ إرث أبي.
يا ابن أبي قحافة! أفي كتابِ الله أن ترثَ أباك ولا أرثُ أبي؟! لقد جئت شيئاً فريّاً.
أفعلى عَمدٍ تركتم كتابَ الله ونبذتموه وراء ظُهوركم؟! إذ يقول الله جلّ جلاله:﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ﴾[680]، ويقول فيما اقتصَّ من خبر زكريا: ﴿عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾[681][682]
وثالثاً: روى المُحدّثون أنّ علياً جاء إلى أبي بكر وهو في المسجد، وحوله حشدٌ من المُهاجرين والأنصار، فقال×: «يا أبا بكرٍ، لِمَ مَنعتَ فاطمة نحلتَها من رسول الله’ وقد ملكَتها في حياته؟»
فقال أبو بكر: فدك فيء للمُسلمين، فإن أقامت شهوداً أنَّ رسول الله أنحلها فلها، وإلّا فلا حقَّ لها فيه.
فقال عليٌّ×: «يا أبا بكر، تحكم فينا بخلاف حُكمِ الله تعالى!»، قال: لا. قال×: «فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه، فادّعيتُ أنا فيه مَن تسأل إليه؟» قال: إيّاك أسأل.
قال×: «فما بالُ فاطمةَ سألتَها البينة منها على ما في يديها، وقد ملكَته في حياة رسول الله’».
فسكت أبو بكر هُنيئة، ثُمَّ قال: يا علي، دعنا من كلامك، فإنّا لا نقوى على حُجّتِكَ، فإنْ أتيتَ بشهودٍ عدول وإلّا فهي فيءٌ للمسلمين، لا حقّ لك ولا لفاطمة بها.
فقال عليٌّ×: «يا أبا بكر، تقرأ كتاب الله!» قال: نعم. قال×: «أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾[683] فيمَن نزلت؟ فينا أو في غيرنا؟» قال: بل فيكم! قال×: «فلو أنّ شُهوداً شهدوا على فاطمةَ بنتِ رسولِ الله’ بفاحشة ـ والعياذ بالله ـ ما كُنتَ صانعاً بها؟»
قال: أقمتُ عليها الحدّ كما أقيم على نساء المسلمين.
قال×: «كنت ـ إذاً ـ عند الله من الكافِرين».
قال: ولِمَ؟ قال: «لأنّك رددتَ شهادةَ الله بطهارتها وقبلت شهادة الناس عليها, كما رددتَ حُكمَ الله وحكم رسوله أن جعلَ لها فدكاً وزعمتَ أنّها فيءٌ للمسلمين، وقد قال رسول الله’ البيّنة على المُدّعي واليمين على مَن اُدّعي عليه».
فدمدم النّاس وأنكروا على أبي بكر، وقالوا: صدق ـ والله ـ عليٌّ[684].
رابعاً: إنّنا نعلم بأنَّ الإمام علياً× هو عيبةُ علمِ رسولِ الله’ وهو الّذي قال فيه النبيّ’ ـ كما نقله عُلماء الفريقين ـ «أنا مدينةُ العلم وعليٌّ بابها، وأنا دار الحكمة وعليّ بابها، ومَن أراد العلم والحكمة فليأتِ الباب»[685].
والحديث النبوي الآخر الّذي اشتهر أيضاً بين المُحدّثين من الفريقين قوله’: «عليّ أقضاكم»[686] فكيف يمكن أن يُبيّنَ النبي’ حكماً خاصّاً في الإرث، وقاضي دَينه، ومنجز عداته، وباب علمه لا يعلم ذلك؟ وخصوصاً الحكم الّذي يكون في شأن فاطمة وهي زوجة أميرِ المؤمنين× وهو وصيّ رسولِ الله؟!
خامساً: نسأل إذا كان الحكم كذلك بأنّ صاحبَ اليد يُطالب بالبيّنة، والمُدّعي يَطلب الشهود، فلماذا لا يسري هذا الحكم إلى جميع المسلمين، مع أنَّ أبا بكر بنفسه قَبلَ ادّعاء جابر بن عبد الله الأنصاري ولم يطلب منه البيّنة، مع أنَّ جابر بن عبد الله الأنصاري ـ مع تقديرنا له واحترامنا لمواقفه ـ ليس إلّا صحابي، لم ينزل فيه القرآن ولم يُطهّره تعالى من الرّجس. ولكن أبو بكر يردّ فاطمة وعلياً÷، ولا يقبل كلامهما في حقٍّ ثابت كثبوت الشّمس في رابعة النهار.
وسادساً: لو كان هذا الحديث الّذي رواه أبو بكر صحيحاً سمعه من رسولِ الله’، فلماذا لم يحكم في سائر ممتلكات النبيِّ’ بُحكم فدك ولم يضمّها إلى بيت المال لعامّة المسلمين، أو يجعلها صدقات يتمتْع بها المساكين، ولكن نرى أنّه ترك حجرة فاطمة لها، وحجرات زوجات الرّسول لكلِّ واحدةٍ منهنَّ الإرث من باب حجرتها.
وسابعاً: إذا كان أبو بكر يؤمن بما يقول، ويعتقد بالحديث الّذي رواه «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة» فلماذا ردَّ فدك ـ بعد أيّامٍ ـ على فاطمة وكتب لها كتاباً في ذلك، إلّا أنَّ عُمر أخذ منها الكتاب ومزّقه ومنعها من التصّرف في فدك، كما رواه في السّيرة الحلبيّة[687] وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة[688]، ولماذا أرجع عمر نفسه فدكاً لأولاد فاطمة‘ بعد موتها ـ كما في كتاب معجم البلدان[689]ـ مع أن عمرَ بصق في كتاب أبي بكر الذي أمر به بإرجاع فدك لفاطمة في زمان حياتهِ!!.
وثامناً وأخيراً: نسألُ ما هو المبرر لأبي بكر في أن يعتدي على أمير المؤمنين ويسبّه، إذا كان له مسوّغٌ في ردّ شهادته، فما هو المسوّغ في سبّه وشتمه وإيذائه؟!
نقل ابن أبي الحديد في شرح النهج عن أبي بكر الجوهري بإسناده إلى جعفر بن مُحّمدٍ بن عُمارة، قال: فلمّا سمع أبو بكر خُطبتها شقَّ عليه مقالتها، فصعد المنبر، وقال: «أيّها النّاس، ما هذه الرعّة إلى كُلِّ قالةٍ؟ أينَ كانت هذه الأماني في عهدِ رسول الله’ ألا مَن سَمِعَ فليقُلْ، ومن شهد فليتكلّم، إنّما هو ثُعالة شهيدُه ذَنبُه، مربّ لكُلِّ فتنةٍ، هو الّذي يقول: كرّوها جذعة بعد ما هرمت، يستعينون بالضُعفاء، ويستنصرّون بالنساء، كأُمِّ طَحال أحبّ أهلِها إليها البغي...!! [690].
ثُمَّ إنَّ ابنَ أبي الحديد يستغرب من جواب أبي بكر، يقول: قرأت هذا الكلام على النقيب أبي يحيى، جعفر بن أبي زيد البصري، وقلتُ له: بمَن يُعرّض؟ فقال: بل يُصرّح، قلتُ: لو صرّح لم أسألك. فضحك وقال: بعليّ بن أبي طالب×، قلتُ: هذا الكلام كلّه لعليٍّ يقوله؟! قال: نعم، إنّه الملك يا بُنيّ! قلت: فما مقالة الأنصار؟ قال: هتفوا بذكر عليّ، فخاف من اضطراب الأمر عليهم...
ثُمَّ قال: فسألتُه عن غريبهِ، فقال: أمّا الرِعةِ ـ بالتخفيف ـ أيّ: الاستماع والإصغاء، والقالة: القول، وثعالة: اسم الثعلب، عَلَمٌ ممنوعٌ من الصرف. وشهيدُه ذنبه أيّ: لا شاهدَ له على ما يدّعي إلّا بعضُه وجزء منه. وأُمّ طحال: امرأة بغيّ في الجاهلية، يُضرب بها المثل فيقال: أزنى من أُمّ طحال!![691]
لا أدري كيف تسنّى لأبي بكرٍ أن يتكلّم بهذا الكلام البذيء؟ وكيف سوّلت له نفسُه أن يُعبِّر بذلك التعبير السيئ، ويؤذي فاطمة ويُغضبها، وقد سمع قولَ رسولِ الله’: «فاطمة بضعة مِنّي مَن أغضبها أغضبني»[692]، وهل بذلك يُجاب احتجاجُ عليّ×؟ بشتمه وسبّه؟ أم بالاستدلال له بحكم الله وبالعقل والمنطق؟!
ولكن كما قال الشاعر:
|
وحسبكم هذا التفاوت بيننا |
وقد قال رسول الله’: «أنا سِلم لمَن سالمهم وحرب لمَن حاربهم»[694] وقد روى كثير من أعلام العامّة ومحدثيهم أنّ النبيَّ’ قال في عليِّ وفاطمة: «مَن آذاهما فقد آذاني، ومَن آذاني فقد آذى الله»[695] «ومَن سبّ عليّاً فقد سبّني، ومَن سبّني فقد سبَّ الله»[696].
وليتهم اكتفوا بالسبّ فقط، بل وصل الأمر بهم إلى أن يمدّوا أيديَهم إلى وجهِ فاطمة الزّهراء‘ فيضربوها، ويكسروا ضلعَها، فرجعت إلى أبيها مُحمرّة العين، مسودّة المتن، ناحلة الجسم، منهدّة الرُكن.
|
رضّوا سليلةَ أحمد بالباب حتّى أنبتوا في صدرها مسمارها |
المحاضرة التاسعة والثلاثون: شذرات من حياة العقيلة زينب‘
|
اليومُ يومٌ حُزنُه لا يذهبُ ماتتْ بهِ أُمُّ المصائبِ (زينبُ) |
زينب بعد يوم الطف ما بطلت بواچيها
لمّن ذبل منها العود اوعمّت كربلاء اعليها
مِن ردَّت لعد يثرب ما هوّدت حسـرتها
ظلّت بس توّن وتنوح ذيچ الطاهره اخوتها
|
|
مصيبتها تهد الحيل |
|
|
عليها تهيّج الذكرى اهموم الچامنه بيها |
|
|
قال الإمامُ زينُ العابدين× لعمّتِه زينب‘: «أنتِ بحمدِ الله عالمةٌ غيرُ معلّمةٍ وفَهِمةٌ غيرُ مُفهّمةٍ»[699].
السيّدة زينب‘ عقيلة بني هاشم، وصريخة عبد المطّلب، وحفيدة الرسول الأعظم’ ابنة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب×، وابنة فاطمة الزهراء البتول‘ زينب الكبرى غنيّة عن التعريف، كالشمس في رابعة النهار.
|
وإذا استطال الشـيء قام بنفسه |
ولدت الحوراء زينب× في الخامس من جمادى الأُولى في السنة الخامسة من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية والثناء، وذلك في المدينة المنورة.
ومن ألقابها الصدّيقة الصغرى، العقيلة، عقيلة بني هاشم، عقيلة الطالبيين والعقيلة هي: المرأة الكريمة على قومها العزيزة في بيتها.
ومن ألقابها أيضاً، العارفة، العالمة، الفاضلة، الكاملة، عابدة آل عليّ.
زوجها عبد الله بن جعفر الطيار الملقّب بالجواد، ويكنّى بأبي مُحمّد، وأشهر كناه أبو جعفر، وأُمّه أسماء بنت عميس الخثعمية، فهو كريم الأصل جواد اليد.
نزل في يوم من الأيام إلى خيمة أعرابية، وكانت عندها دجاجة وقد أمسى عندها، فذبحتها وجاءت بها إليه، وقالت: يا بن جعفر، هذه دجاجة كنت أطعمها من قوتي وألمسها في آناء الليل، فكأنّما ألمس بنتاً نزلت من كبدي، فنذرت لها أن أدفنُها في أكرم بقعة، فلم أجد تلك البقعة المباركة إلّا بطنك، فأردت أن أدفنها فيه، فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسمائة درهم[701].
ولدت العقيلة زينب الكبرى لعبد الله بن جعفر الطيار عليّاً وعوناً الأكبر وعبّاساً، وأُمَّ كلثوم.
أما عون فقد استُشهد مع خاله الحسين في كربلاء يوم الطفّ، قُتل في جملة آل أبي طالب[702].
ولما ولدت الحوراء زينب‘ استبشر بها أبوها الإمام عليّ× وأخذها من أُمّها السيدة فاطمة الزهراء‘ إذ قالت: «سمِّ هذه المولودة»، فقال: «ما كنتُ لأسبق أباكِ رسولَ الله’» وكان في سفر لـه، وأجرى عليها مراسيم الإسلام في المولود، فقد أذّن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى.
ولمّا جاء النبيّ’ احتضنها، وسأل الإمام عليّاً× عن اسمها، قال: «ما كنت لأسبقكَ يا رسول الله»، فقال’: «ما كنتُ لأسبق ربّي تعالى»، فهبط الأمين جبرائيل يقرأ على النبيّ السلام مِن الله الجليل العلّام، وقال له: «سمِّ هذه المولودة زينب، فقد اختار الله سبحانه لها هذا الاسم».
ثُمَّ أخبره بما يجري عليها من المصائب، فبكى النبيّ’، وقال: «مَن بكى على مصاب هذه البنت كان كمَن بكى على أخويها الإمامين الحسن والحسين÷»[703].
هكذا يُشير النبيّ الأكرم’ إلى ثواب الباكي على العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين×.
نسبُها من خير الأنساب وزوجها من خير الأزواج، فجدّها الرسول الأعظم’ وأبوها أمير المؤمنين× وأُمّها فاطمة الزهراء‘ وإخوتها الحسن والحسين÷.
وإذا ضممنا إلى ذلك كُلّه علمها وفضلها وورعها وعبادتها وتقواها وعمق معرفتها بالله تعالى كان لشرفها شرفٌ خاصٌّ لا يبلغ كنهه العادّون، ولا يحصيه المُحصون إلّا مَن كان من أهل بيت العصمة والطهارة.
وممّا زاد في شرفها أنّ الخمسة الطاهرين أهل الكساء كانوا يحبّونها حبّاً جمّاً، ويكفيك معرفة في عفّتها ما رواه يحيى المازني قال: جاورت أمير المؤمنين علياً× في المدينة المنوّرة مدّة مديدة وبالقرب من البيت الذي تسكنه ابنته السيدة زينب، فلا والله، ما رأيت لها شخصاً ولا سمعت لها صوتاً، وكان إذا أرادت الخروج لزيارة جدّها تخرج ليلاً، الحسن عن يمينها والحسين عن شمالها، وأمير المؤمنين× أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف، سبقها أمير المؤمنين× فأخمد ضوء القناديل، فسأله الإمام الحسن× مرّة عن ذلك، فقال: «أخشى أن ينظر أحد إلى شخص أُختك زينب»[704]. وجاء في بعض الأخبار، أنّ الإمام الحسين× إذا زارته أخته زينب يقوم لها إجلالاً ويجلسها في مكانه[705].
وقد شاركت أُمّها الزهراء‘ في هذه المرتبة عندما كان يقوم رسول الله’ حينما تدخل فاطمة يُجلسها في مكانه، وفي بعض الأخبار يقبِّلها ويُجلِسها في مكانه[706].
ومن هنا سمّيت الحوراء زينب‘ بالصدّيقة الصغرى؛ لاقترانها بعدّة صفات من صفات أُمّها فاطمة الزهراء‘، حيث كانت أُمُّها الصدِّيقة الكبرى.
وأمّا علمُها ومعرفتُها بالله تبارك وتعالى فهي المتربيّة في مدينة العلم النبويّ، المعتكفة بعده ببابها العلويّ، المتغذّية بلبانه من أُمّها الصدّيقة الطاهرة‘، وقد طوت عُمراً من الدّهر بين الإمامين السّبطين، فهي من عيبة علم آل مُحمّد’، وفضائلهم التي اعترف بها عدوّهم الألدّ يزيد الطاغية بقوله في الإمام السجاد×: «إنّه من أهل بيت زقّوا العلم زقّاً»[707].
ويكفينا في المقام كلمة الإمام السجاد× التي افتتحنا بها كلامنا حيث قال: «أنتِ بحمدِ الله عالمةٌ غيرُ معلَّمةٍ وفَهِمةٌ غيرُ مُفهّمةٍ»، معنى ذلك أنّ علمك من الله وفهمك كذلك. فالإمام× يريد أن يشير إلى أنّ مادّة علمها من سنخ ما مُنح رجالات بيتها الرفيع أُفيض عليها إلهاماً.
ولا شكَّ أنّ الذّي يخلص لله أربعينَ صباحاً جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه[708]، فكيف بالحوراء زينب التي أخلصت لله في كلّ أطوار عمرها وأدواره ، فما ظنّك بالمتفجر من قلبها‘؟!
وروي أنّها في طفولتها كانت جالسة في حجر أبيها ـ وهو× يلاطفها بالكلام ـ فقال لها: «يا بنيَّتي قولي: واحد». فقالت: «واحد». فقال لها: «قولي اثنين». فسكتت، فقال لها: «تكلّمي يا قرّة عيني». فقالت‘: «يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد». فضمّها ‘ إلى صدره وقبّلها بين عينيها[709].
وإنّ زينب‘ـ في رواية أُخرى ـ قالت لأبيها: «أتحبّنا يا أبتاه؟» فقال×: «وكيف لا أحبّكم وأنتم ثمرة فؤادي!» فقالت‘: «يا أبتاه، إنّ الحبّ لله تعالى والشفقة لنا»[710].
وإذا تأمّل المتأمّل هذا الكلام رأى فيه علماً جمّاً، فإذا عرف صدوره من طفلة كزينب‘ يوم ذاك بانت لـه منزلتها في العلم والمعرفة[711].
وأمّا مشاطرتها لمصائب أخيها الحسين× فهي بيت القصيد، وهي أبرز مَعلَم من معالم حياة الحوراء زينب‘، حتّى أنّها تحمّلت ما يضعف عن حمله الرجال.
ورحم الله الشاعر حيث يقول:
|
ولـو أنَّ النسـاءَ كَمـنْ ذكَـرنـا |
فلا مبالَغة في أنْ نقول: إنّ الحوراء زينب كانت شريكة أخيها الحسين في نهضته، ومشاطِرة له في جهوده التي بذلها في سبيل تحقيق أُمنيّته، ولولا الإمام زين العابدين× والحوراء زينب‘؛ لذهبت جهود الإمام الحسين× أدراج الرياح، إذ أنّ يزيد وأتباعه ـ وهم أتباع معاوية ـ أشاعوا بأن الحسين× خارجيّ خرج على سلطان المسلمين، وإذا بصوت الإمام زين العابدين× وصوت الحوراء زينب‘ يجلجل في ذلك الجو الصاخب، ويدوّي في مجلس يزيد الحاشد بجماهير الوفود والمتفرّجين والمهنّئين لـه في عيده عيد الظفر، فألقى الإمام زين العابدين× خطبته التي فضح بها يزيد، وكذلك صنعت الحوراء زينب‘.
وقد يعترض البعض قائلاً: أليس في زين العابدين× كفاية لإتمام مهمّة الحسين والقيام بها عن حمل زينب معه فضلاً عن غيرها من النساء، مع أنّه إمام زمانها وحجّة عصرها، وأين قوّة إرادة الإمام من المأمومين؟!
وهذا الاعتراض مردود بالآتي:
أولاً: بالنقض برسول الله’ فإن الله قد زوّده ـ لمّا أراد إرساله ـ من القوّة البشرية فضلاً عن الإلهية بما يستطيع أن يقابل بها الجيوش وحده، فلماذا يدعو النّاس أن يجيروه من أيدي الأعداء والاعتداء ليبلّغ رسالته السماويّة؟ ولماذا يدعو لنصرته المستضعفين من النساء والصبيان؟!
وثانياً: فإنّ زينب قد قامت بأعمال كثيرة ليس من شأن الإمام زين العابدين× القيام بها إلّا من باب المُعجزة، وقد شاء الله أن يسير دينُه في الخلق سيراً طبيعياً.
ومن الأُمور التي قامت بها الحوراء زينب‘ على نحو الاختصار لا الحصر:
1ـ لقد ألقى الإمام الحسين× على عاتقها مسؤولية حفظ عياله وأطفاله، وما كانت تنهض بهذا العبء الثقيل، وهي في مثل تلك الحالة لو لم يستجب الله دعاءه لها بأن يربط على قلبها بالصبر حينما ناءت بهذا الحمل الثقيل، فأخبر عنها حجّة عصرها الإمام زين العابدين× أنّه عاد قلبها بعد مصرع الحسين كزبر الحديد، وبهذا الصبر كافحت تلك الخطوب وثبتت لتلك الأهوال، ولم تخر قواها أمام تلك الفوادح، ولم تتزلزل جبال حلمها بهاتيك العواصف، ولم تتحرَّك قيد شعره لتلك القواصف.
|
بأبي التي ورثتْ مصائب أُمّها |
2ـ ما جاء في كثيرٍ من الأخبارِ أنّ الحوراء زينب‘ قامت مقام أخيها في ترويج أحكام الشريعة، وكانت الكهف الذي يأوي إليه الكثيرُ من المسلمين والشيعة في المُلمّات، وأنّها حملت الكثير من وصايا أخيها الحُسين، حتّى أدّتها إلى خليفته زين العابدين، وأنّها كانت الحجّة الظاهرة والقائمة مقام إمام زمانها وحجّة عصرها السجاد×.
3ـ وكانت مع هذه الشواغل التي تفتّ الصخر الأصمّ؛ من حماية الأطفال واليتامى، وتسلية الثواكل، إلى غير ذلك، تنوب عن أخيها الحسين× في وفادة وفوده وهم الكثرة الهائلة من النّاس ومنهم مَن له عادة سنوية.
وفي يوم من الأيام طرق أحدهم الباب، وعرفت زينب أنّه أحد الوفود لأخيها الحسين الذين يفدون عليه في كلّ عام مرّة، دفعت له من وراء الباب قلادة، وقالت له: خذها وانصرف إلى أهلك فإنّ صاحب المنزل غائب. قال: أنتظره أيّاماً، قالت: ما يعود، قال: فأسبوعاً، قالت: ما يعود. وأخذ كلمّا زاد في آجال الانتظار والوعود أجابته زينب ـ بحرقة وشجىً مضاعف قائلةً: ما يعود، حتّى انتهى الأمر به من الأسابيع إلى الأشهر المتعدّدة ووصل إلى العام، وهو في تلك المراجعات يضع على جُرح فؤادها جرحاً ويذرّ عليها بكثرة إلحاحه مِلحاً، ولم يكن ذكيّاً ليعرف المعنى الذي ترمي إليه، بل كان حريصاً أشدّ الحرص على حضور مولاه والمثول بين يديه؛ ليُسرّح طرف ناظره برياض قسماته، ويتمتّع بسماع حديثه الشهي، إلى أن انتهى بها الجواب أنّه لا يعود ولو بعد عام، أحسّ قلبه بالكرب والبلاء، ولم يكن خياله ليحدّثه بأنّ تلك الكف الكريمة يأكلها التراب والبلاء، وكأنّه كان نائماً فاستيقظ، فسألها بلهفة التطلّع وحرقة السؤال. قال لها: إذن قولي: مات مولاي الحسين؟
قالت له: ويحك، ويحك أيّها الوافد، إنّ الأمر فوق ما تظنّ، والخطب أجل وأعظم ممّا تتصوّر، فهل تستطيع أن تسمع جوابها لك «عظّم الله أجرك بمولاك الحسين فقد قُتل في كربلاء عطشاناً غريباً، وقُتل معه أهل بيته ولم يرجع إلى أوطانهم إلّا نساؤهم الأيامى وأطفالُهم اليتامى»[712].
بقيت الحوراء زينب‘ على هذه الحالة محزونة مكروبة إلى أن أخذ الزمان بها وبزوجها عبد الله أن يزورا الشّام، وفي الطريق نظرت الحوراء زينب‘ إلى شجرة، التفتت إلى ابن عمّها قالت له: أترى هذه الشجرة وهي مختنقة بعبرتها؟ قال لها: بلى، قالت له: هذه الشجرة قد علّقوا عليها رأس الحسين×، دارت بها الذكريات وذكرت تلك الساعات التي طاف بها القوم في تلك الديار، وما كان يغمرها عندها من الآلام والأحزان.
فطلبت من زوجها أن يسّتقرَّ بها عند هذه الشجرة، فاستجاب ابن عمّها لها، آه آه:
|
من وصلت لأراضي الشّام اوشافت عينها الشجره |
***
|
ماتت
عزيزة حيدر اليوم |
***
(بحراني)
يا آل هاشم ما تجون ابسود الأعلام
ماتت عقليتكم غريبه ابّلدة الشّام
من عُگب وقعة كربلا ظلّت حزينه
اتحنّ اعلى حنتها جميع أهل المدينه
اوتصدع المرمر من تصيح احسين وينه
اووين النفل عبّاس والأكبر وجسّام
راحت ليالي السعد وياهم والأفـراح
اوصيوان عزنه الچان يا ويلي هوه اوطاح
ابگلبي اجروح ايفور دمها اشلون أرتاح
جرح السيوف ايهون عنها وجرح السهام
***
|
هاجَ وَجْدي لِزينبَ إذ عراها |
المحاضرة الأربعون: شذرات من حياة السيدة فاطمة المعصومة
|
لهفَ نفسـي لبنتِ (موسى) سَقاها |
اووصـلت بلد قم اوأجوها |
قال الإمام أبو عبد الله الصّادق×: «إنّ لله تعالی حَرماً وهو مكّة، وإنّ للرسول’ حَرماً وهو المدينة، وإنّ لأمير المؤمنينَ× حَرماً وهو الكوفة، وإنّ لنا حَرماً وهو بلدة قُم. وستُدفنُ فيها امرأةٌ من أولادي تـُسمّی فاطمة، فمَن زارها وجبت له الجَنّة»، قال الراوي: وكان هذا الكلام منه قبل أن يُولد الكاظم ×[715].
فاطمة المعصومة‘، هذه السيّدة الجليلة والامرأة النبيلة، ذات المقام الشامخ، والمنزلة العالية عند أهل بيت العصمة والطهارة^، أفضل بنات الإمام موسی بن جعفر×، علی ما وصل إلی أيدي العُلماء[716] من حثٍّ علی زيارتها، وتعريفٍ بمقامها الشامخ، حتّی وصل الأمر إلی أنّ الزائر لها وجبت له الجنّة[717].
وهي فاطمة بنت الإمام موسی بن جعفر×، المعروفة بالمعصومة‘ وهي قرّة عين أهل قم، وملاذ النّاس ومعاذهم، تُشدّ إليها الرحال في كلّ سنة، بل في كلِّ يوم من الأماكن البعيدة لاقتباس الفيض، واكتساب الأجر في زيارتها‘.
ولدت فاطمة المعصومة‘ في الأوّل من شهر ذي القعدة سنة (173ﻫ)، فسُرَّ بها الإمام الكاظم× سُروراً عظيماً، وانتقلت الفرحة والبهجة التي لا تقل عن فرحة الأب إلی أُمّها نجمة التي تلطـّف عليها الباري بالمولود الثاني بعد خمس وعشرين سنة من ولادة إمامنا الرضا×، حيث كانت ولادته× في شهر ذي القعدة من سنة 148ﻫ.ق، وقد سُرّت (نجمة) به سروراً لا مثيل له، والآن وبعد مضي تلك السنين المديدة مَنَّ الله تعالیعليها وعلی الإمام الكاظم × بمولودةٍ تكون أختاً للإمام الرضا×.
ولأجل العلاقة الخاصّة بين الإمام الكاظم× وجدّته فاطمة الزهراء‘ سمّی الإمام× ابنته الجديدة (فاطمة) تيمّناً بفاطمة الزهراء (روحي فداها)، وهذا ديدن الأئمّة^، ولعلّك لا تجد إماماً إلّاوقد سمّی واحدة أواثنتين من بناته بفاطمة، وهذا ناشيءٌ من العلاقة الحميمة بين الأئمّة^ وأمّهم الصدّيقة الكبری فاطمة الزهراء‘.
ولفرط تقوی هذه السيّدة الجليلة وصلاحها عُرفت فيما بعد بـ (المعصومة)، واقتدت بأبيها في العصمة عن الرجس من كلّ إثمٍ ولمم.
ولهذا الاسم (فاطمة) عند أهل البيت^ شجاهُ الخاصّ بما يحمل ويحكي من ذكريات حلوةٍ ومرّةٍ تعرّضت لها الصدّيقة فاطمة الزهراء، هذه الصدّيقة الكبری، حتّی أنّهم^ كانوا إذا سمّوْا واحدة من بناتهم بفاطمة حظيت بمكانةٍ خاصّة من الإحترام والتقدير، لعلّها لا تدنو إليها منزلة وتقدير سائر بناتهم^، والسيدة المعصومة‘ لم تكن مستثناة من تلك العادة الحسنة والطريقة الصائبة عند أهل البيت^، فإنّها‘ حظيت من أبيها بتربيةٍ خاصّةٍ، ورعايةٍ صالحةٍ لا نظير لها[718].
عاشت السّيدة المعصومة في كنف والديها الكريمين ـ الإمام الكاظم × ونجمة1 ـ تكتسب منهما الفضائل والمكارم؛ إذ كان أبوها إماماً معصوماً، وليس له في الفضائل والتقی من نظير، وأمّها نجمة أيضاً من النساء الصالحات المؤمنات اللواتي تعلّمْنَ في مدرسة أهل البيت^، وبالخصوص في مدرسة الإمام جعفر الصّادق×، وبالخصوص عند زوجة الإمام الصّادق×، أُمّ الإمام الكاظم×، والتي اختارها الإمام الباقر×، والتي كان يُعبّرُ عنها الإمام الصّادق× قائلاً: «حَميدة مصفّاة من الأدناس كسبيكة الذّهب مازالت الأملاك تحرسها...»[719].
وهذه المرأة المصفّاة هي أُمّ الإمام الكاظم×، وهي التي أشارت عليّه× أن يتزوّج بـ (نجمة).
فكانت السيدة المعصومة‘ تستفيد كُلَّ يومٍ من والدها وأخيها المعصومين÷ وأُمّها التقية الصالحة العالمة، بحيث نالت المقام الرفيع والمنزلة العالية من العلم والمعرفة والفضيلة وصارت عارفة ًبالكثير من العلوم والمسائل الإسلامية في أيّام صباها.
ومن هذه الدلائل ما حدث في أحد تلك الأيّام حيث أتی جمع من الشيعة إلی المدينة؛ لكي يعرضوا بعض أسئلتهم الدينية علی إمامهم آنذاك، وهو الإمام الكاظم× حتّی يأخذوا العلم من معدنه وأصله، إلّا أنّ الحظّ لم يُحالفهم، إذ أنّ الإمام الكاظم× وابنه الإمام الرضا× كانا في سفرٍ ولم يكونا حاضرين في المدينة، فاغتمّ الجمع الصالح من شيعة أهل البيت^؛ لأنّهم لم يعثروا علی ضالتهم المنشودة حيث لم يجدوا حجّة الله، ومَن يقدر علی جواب مسائلهم.
فاضطرّوا للتفكير جدّاً بالرجوع إلی بلدهم، وعندما عرفت السيدة المعصومة‘ حُزن هؤلاء النفر من الشيعة أخذت منهم أسئلتهم التي كانت عندهم مكتوبة وأجابت عنها برمّـتها، وعندئذٍ تبدّل حُزن الجماعة بفرح ٍشديد ورجعوا ـ بعد ما ظفروا علی أجوبةٍ لمسائلهم ـ فرحين ومسرورين إلی بلادهم وديارهم، وفي الطريق التقوا بالإمام الكاظم× خارج المدينة وحدَّثوه بما جری عليهم من أجوبة ابنته المعصومة‘ لمسائلهم، وبعد ما رآی الإمام الكاظم × جواب ابنته علی تلك المسائل أثنی عليها بعبارة مختصرة، وهي: «فداها أبوها»[720]، ولكن هذه العبارة مع اختصارها تحمل أسراراً كثيرة؛ إذ كيف يقولها الإمام× لولا أنّه رأی أنّها تستحقّ ذلك، وهذه من تعابير النبيّ الأكرم’ بحقّ الزهراء‘.
لكن بعد هذا العزّ وتلك المنزلة ـ ولقاعدة أنّ الدنيا صفوها لا يدوم لأحد ـ فقدت أباها الإمام الكاظم×، وانتقلت الإمامة إلی ابنه الإمام الرضا×، الذي كان في الخامسة والثلاثين من عُمره الشريف، وكان× ـ بالإضافة إلی إمامته الإلهية وهِداية الأُمَّة الإسلامية ـ الوصيَّ الوحيد لأبيه الكاظم× الذي يتولّی مسؤولية أبناء الإمام الكاظم× إخوانه وأخواته، ومنهم السيّدة الجليلة فاطمة المعصومة‘ وكانت تـُحبّ الإمام الرضا× حبّاً خاصّاً، ولمّا حمله المأمون إلی خراسان[721] قسراً ليسلّمه ولاية العهد ـ والتي كانت مؤامرة علی أهل بيت العصمة والطهارة‘ غير خفية عليهم ولا علی خواصّهم ـ اشتدّ شوقها إلی أخيها الإمام الرضا×؛ فخرجت في أثره، وذلك في سنة (201ﻫ)، كما حدَّث بذلك العلّامة المجلسي&، وكانت قد قطعت تلك المفاوز والصحاري، ووجه أخيها الإمام الرضا× يتراءى لها ممّا أدّی بها إلی مواصلة المسير لبصيص الأمل هذا.
فلمّا وصلت إلی (ساوة) وهي قرية من قری قم، مرضت فسألت كم بيني وبين قم ؟ قالوا: عشرة فراسخ[722]، فأمرت خادمها فذهب بها إلی قم، ولمّا وصل الخبر إلی آل سعدٍ أنّ فاطمة بنت موسی بن جعفر تنزل في بلدة قم، اتّفقوا وخرجوا وكلّ منهم يطلب نزولها عنده في داره، فخرج من بينهم موسی بن خزرج وأخذ بزمام الناقة ـ ناقتها ـ وجرّها إلی قم وأنزلها في داره، وكانوا مسرورين لدخول السيدة فاطمة‘ دارهم.
وكان موسی بن خزرج ذا يُسرٍ وبيتٍ وسيع، وأنزل السيدة في داره، وتكفّل بضيافتها ومرافقتها، واستشعر موسی بن خزرج فرط السعادة بخدمته لضيوف الإمام الرضا× القادمين من المدينة، وهيّأ لهم كلّ مايحتاجونه.
واتّخذت السيدة فاطمة المعصومة‘ معبداً لها في منزل موسی بن خزرج؛ لكي تبتهل إلی الله}، وتعبده وتناجيه وتشكو إليه ألآمها وتستعينه علی ما ألمّ بها.
وهذا المعبد باقٍ وموجود إلی الآن ويسمّی بـ(بيت النور)[723].
الی أن مرضت بنت الإمام موسی بن جعفر× مرضاً شديداً حتی أقلق مُرافقيها وأهالي قم كثيراً مع أنّهم لم يبخلوا عليها بشيءٍ من العلاج، إلّا أنّ حالها يزداد سوءً، يوماً بعد يوم؛ لأنّ المرض قد تجذّر في بدنها الشريف، وفي العاشر من ربيع الثاني سنة (201ﻫ) توفيت السيدة المعصومة‘ دون أن تری أخاها، وما زالت دمعة عينها لفراق أخيها مغرورقة في الأحداق بعد أن أحاطها الدهر بمصائبه من كلّ جانبٍ. أُفجع أهلُ قم بتلك المصيبة، وفي غاية الحزن لوفاتها أقاموا العزاء عليها، وأمر موسی بن خزرج بتغسيلها وتكفينها ثُمَّ صلّی عليها موسی بن خزرج في حشدٍ كبير من شيعة أهل البيت^ في قم المقدّسة، ولكن اختلفوا بالذي ينزلها في قبرها ويدفنها.
تبادل الحاضرون الرأي وأخيراً اتّفقوا أن يوكلوا هذا العمل إلی شيخٍ كبير صالح اسمه (قادر)، وأرسلوا شخصّاً لإحضاره، ولكنّ مشيئة الله كانت غير ذلك، فلم يجدوا هذا الرجل الصالح، فبينما هم كذلك وإذا بفارس مُلثم ٍأقبل إلی الجنازة، فتولّی إنزالها في القبر، ثُمَّ أهال التراب عليها وعاد من حيث أتی ولا أحدٌ يدري مَن هو[724].
|
صار الهم عليها من البچه ويد |
نعم، لقد ماتت السيّدة فاطمة المعصومة‘ غريبة، ولكن شاء الله أن يكون لها قبرٌ شامخ يؤمّه ألآف الـنّاس كلّ يوم، ولكن أسفي علی فاطمة الزهراء‘ التي ماتت بين أهلها وأصحاب أبيها، وليس لها قبر معروف يقصده الزائرون!!
(أبوذية)
|
عگب عـزها عليها الدهر ينصاب اوحماها مگيد اِبحبل الوصيه |
***
|
ولأيّ الأُمور تـُدفنُ سِرّاً |
تمَّ الكتابُ بعونِ الله الملكِ الوهّاب
بقلم المذنب كاظم البهادلي
القرآن الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى.
نهج البلاغة، الإمام أمير المؤمنين عليُّ بن أبي طالب× المستشهد سنة (40ﻫ)، تحقيق الشيخ محمّد عبدة، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.
الصّحيفة السّجادية، الإمام زين العابدين عليّ بن الحسين× المستشهد سنة (94ﻫ)، المطبعة والناشر جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
ـ حرف الألف ـ
1 ـ إبصار العين في أنصار الحسين، الشيخ محمّد السماوي (ت 1370ﻫ) تحقيق الشيخ محمد جعفر الطبسي، الطبعة الأُولى 1419ﻫ ـ 1377 ش، منشورات حرس الثورة الإسلامية.
2ـ الآحاد والمثاني، الضحّاك (ت 287ﻫ) تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة، الطبعة الأُولى 1411ﻫ ـ 1991 م، منشورات درّ الدراية للطباعة والنشر والتوزيع، السعودية ـ الرياض.
3 ـ الاحتجاج، الشيخ الطبرسي (ت 548ﻫ) تحقيق وتعليق السيّد باقر الخرسان، منشورات دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف، سنة 1386ﻫ .
4 ـ أحكام القرآن، الجصّاص (ت 370ﻫ) تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين الطبعة الأُولى 1415ﻫ ـ 1995م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
5 ـ الأخبار الطوال، أبو حنيفة، أحمد بن داود الدينوري (ت 282ﻫ) تحقيق عبد المنعم عامر، الدكتور جمال الدين الشيّال، الطبعة الأُولى1960 م، منشورات دار إحياء الكتب العربي، منشورات الشريف الرضي.
6 ـ الاختصاص، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان البغدادي (ت 413ﻫ) تحقيق عليّ أكبر الغفاري، انتشارات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة، قم المقدّسة.
7 ـ الأخلاق الحسينيّة، جعفر البياتي (معاصر) الطبعة الأُولى 1418ﻫ ، منشورات أنوار الهدى.
8 ـ الأخلاق والآداب الإسلامية، هيئة محمّد الأمين، الطبعة الثانية، 1421ﻫ ـ 2001م، مكتبة الأمين، قم ـ إيران.
9 ـ الإخوان، ابن أبي الدُّنيا (ت 281ﻫ) تحقيق محمد عبد الرحمن طوالبه، بإشراف نجم عبد الرحمن خلف، انتشارات دار الاعتصام.
10 ـ أدب الطفّ، السيد جواد شبّر، الطبعة الأُولى 1398ﻫ ـ 1978 م، دار المرتضى، بيروت ـ لبنان.
11 ـ الأدب المفرد، البخاري، محمد بن إسماعيل، الطبعة الأُولى 1406ﻫ ـ 1986م، منشورات مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ـ لبنان.
12 ـ الإرشاد، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان البغدادي (ت 413ﻫ) تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ قم المقدّسة، الطبعة الأُولى 1417ﻫ .
13 ـ أسباب النزول (الواحدي) أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، (ت 468ﻫ) مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع ـ القاهرة.
14 ـ الاستبصار، الشيخ الطوسي، (ت 460ﻫ) تحقيق وتعليق السيد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الرابعة 1363ﻫ ش، منشورات دار الكتب الإسلامية، طهران.
15 ـ الاستيعاب، ابن عبد البرّ (ت 463ﻫ) تحقيق علي محمد اليماوي، الطبعة الأُولى 1412ﻫ ، منشورات دار الجيل، بيروت ـ لبنان.
16 ـ أُسد الغابة، ابن الأثير، (ت 630ﻫ) منشورات دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
17 ـ الأسرار الفاطمية، الشيخ محمّد فاضل المسعودي (معاصر) الطبعة الثانية 1420ﻫ ، منشورات مؤسسة الزائر في الروضة المقدّسة للسيّدة فاطمة المعصومة‘، قم المقدّسة.
18 ـ الاعتقادات، الشيخ الصدوق، محمد بن بابويه القمّي (ت381ﻫ) نشر وتحقيق غلام رضا المازندراني، المطبعة العلمية، قم المقدّسة 1412ﻫ .
19 ـ إعلام الورى، الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 548ﻫ) تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة.
20 ـ أعيان الشيعة، السيد محسن الأمين (ت 1371ﻫ) تحقيق السيّد حسن الأمين منشورات دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
21 ـ إقبال الأعمال، السيد ابن طاووس (ت 664ﻫ) تحقيق محمّد جواد القيّومي، الطبعة الأُولى 1414ﻫ، منشورات مكتب الإعلام الإسلامي.
22 ـ إكسير المحبّة، مجهولة.
23 ـ أمالي الشيخ الصدوق، محمّد بن عليّ بن بابويه القُميّ، (ت 381ﻫ) الناشر مؤسسة البعثة، الطبعة الأُولى 1417ﻫ، تحقيق قسم الدارسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم المقدّسة.
24 ـ أمالي الشيخ الطوسي، الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي (ت 460ﻫ) الطبعة الأُولى 1414ﻫ، تحقيق مؤسسة البعثة، منشورات دار الثقافة.
25 ـ أمالي الشيخ المفيد، محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 413ﻫ) تحقيق حسين الاستادومي، علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية 1414ﻫ ـ 1993م، منشورات دار المفيد، بيروت ـ لبنان.
26 ـ الإمامة والسياسة، ابن قُتيبة الدينوري (ت 276ﻫ) تحقيق طه محمّد الزيني، منشورات مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع.
27 ـ الانصاف فيما تضمّنه الكشّاف، ابن المنير الأسكندري (ت 683ﻫ) منشورات مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
28 ـ أنوار البدرين، الشيخ عليّ البحراني ( 1340ﻫ) تحقيق محمّد علي الطبسي، سنة الطبع 1377ﻫ في مطبعة النعمان، النجف الأشرف.
29ـ الأنوار القدسية، الشيخ محمد حسين الأصفهاني (ت 1320ﻫ) تحقيق الشيخ علي النهاوندي، الطبعة الأُولى 1415ﻫ ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم ـ إيران.
30 ـ آيات منتخبة، السيد مهدي الخطيب الهنداوي (ت 1427ﻫ)، مطبعة ستارة، قم المقدّسة ، الناشر المؤلف&.
31 ـ إيضاح الفوائد، فخر المحقّقين، محمد بن الحسن بن المطهّر الحلّي (ت771ﻫ) تحقيق وتعليق السيّد حسين الموسوي الكرماني، الشيخ علي پناه الأشتهاردي، الشيخ عبد الرحيم البروجردي، الطبعة الأُولى 1387ﻫ ، المطبعة العلمية، قم المقدّسة.
ـ حرف الباء ـ
32 ـ بحار الأنوار، العلّامة المجلسي، محمد باقر (ت1111ﻫ) الطبعة الثانية المصحّحة سنة 1403ﻫ ، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان.
33 ـ البداية والنهاية، الحافظ أبو الفداء ابن كثير الدمشقي (ت 774ﻫ) الطبعة الأُولى 1408ﻫ ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
34 ـ بشارة المصطفى، محمد بن علي الطبري الإمامي (ت 525ﻫ) تحقيق جواد القيومي الأصفهاني، الطبعة الأُولى 1420ﻫ ، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
35 ـ بصائر الدرجات، الشيخ محمّد بن الحسن الصفّار، (ت 290ﻫ) تحقيق ميرزا محسن كوچه باغي، الطبعة 1362ﻫ ش 1404ﻫ ق منشورات مؤسسة الأعلمي، طهران.
36 ـ بغية الباحث، الحارث بن أبي سلمة (ت 282ﻫ) تحقيق مسعد عبد الحميد محمّد السعدني، منشورات دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصوير، القاهرة.
37 ـ بلاغات النساء، أبو الفضل ابن طاهر، المعروف بابن طيفور (ت 380ﻫ)، منشورات مكتبة بصيرتي، قم المقدّسة.
38 ـ بناء المقالة الفاطمية، السيد ابن طاووس (ت 664ﻫ) تحقيق السيد علي العدناني الغريفي، الطبعة الأُولى 1411ﻫ ـ 1991م، منشورات مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة.
ـ حرف التاء ـ
39 ـ تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي (ت 1205ﻫ) الناشر مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان.
40ـ تاريخ الإسلام، الذهبي، (ت 748ﻫ) تحقيق د. عُمر عبد السلام تدمري، الطبعة الأُولى 1407ﻫ 1987 م. منشورات دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
41 ـ تاريخ الطبري، ابن جرير الطبري (ت 310ﻫ) تحقيق نخبة من العلماء، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان.
42 ـ تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، (ت 571ﻫ) تحقيق عليّ شيري، الطبعة الأُولى 1417ﻫ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، منشورات محمّد علي بيضون.
43 ـ تحرير الأحكام، العلّامة الحلي (ت 726ﻫ) تحقيق الشيخ إبراهيم البهادري، إشراف الشيخ جعفر السبحاني، الطبعة الأُولى 1420ﻫ ، منشورات الإمام الصادق ×، قم المقدّسة.
46 ـ التحصيل في أيام التعطيل، السيد علي نقي الطبسي، مجهولة.
47 ـ تحف العقول، ابن شعبة الحرّاني، المتوفى في القرن الرابع، تحقيق علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية 1363 ش، 1404ﻫ، منشورات جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
48 ـ تحفة الأحوذي، المباركفوري، (ت 1282ﻫ) الطبعة الأُولى 1410ﻫ ـ 1990م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
49 ـ التحفة السنية، السيد عبد الله الجزائري (1180ﻫ) مخطوط.
50 ـ تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّي (ت 726ﻫ) تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ الطبعة الأُولى 1414ﻫ ، قم المقدّسة،.
51 ـ تذكرة الموضوعات، الفتني، محمد طاهر بن علي الهندي (ت 986ﻫ) مجهولة.
52 ـ ترتيب إصلاح المنطق، ابن السكّيت الأهوازي (ت 244ﻫ) تحقيق الشيخ محمد حسن بكائي، الطبعة الأُولى 1412ﻫ ، منشورات مجمع البحوث الإسلامية، مشهد المقدّسة ـ إيران.
53 ـ ترجمة الإمام الحسين (ابن عساكر)، ابن عساكر (ت 571ﻫ) تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي، الطبعة الأُولى 1400ﻫ ـ 1980 م، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.
54 ـ ترجمة الإمام الحسين (طبقات ابن سعد)، ابن سعد (ت 230ﻫ) تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي، الطبعة الأُولى، منشورات الهدف للإعلام والنشر.
55 ـ التعجّب، أبو الفتح الكراجكي (ت 449ﻫ) تحقيق فارس حسّون كريم.
56 ـ تفسير أبي السعود، أبو السعود، (ت 951ﻫ)، طباعة ونشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
57 ـ تفسير أبي حمزة الثمالي، أبو حمزة الثمالي، ثابت بن دينار (ت 148ﻫ) تحقيق عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين، الشيخ محمد هادي معرفة الطبعة الأُولى 1420ﻫ ، منشورات الهادي، قم المقدّسة.
58 ـ تفسير الإمام العسكري×، المنسوب للإمام العسكري× (ت260ﻫ) الطعبة الأُولى 1409ﻫ تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي× قم المقدّسة.
59 ـ تفسير الأمثل، الشيخ مكارم الشيرازي، معاصر، طبعة جديدة منقّحة مع إضافات.
60 ـ تفسير البحر المحيط، أبو حيّان الأندلسي (ت 745ﻫ)، تحقيق مجموعة من المحقّقين، الطبعة الأُولى 1422ﻫ ـ 2001م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
61 ـ تفسير البرهان، السيد هاشم البحراني (ت 1107ﻫ) الطبعة الأُولى 1419ﻫ، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان.
62 ـ تفسير البيضاوي، البيضاوي (ت 682ﻫ) منشورات دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
63 ـ تفسير التبيان، الشيخ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، (ت 460ﻫ) تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، الطبعة الأُولى 1409ﻫ ، مكتب الإعلام الإسلامي.
64 ـ تفسير الثعلبي، الثعلبي (ت 427ﻫ) تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير الساعدي، الطبعة الأُولى 1422ﻫ ـ 2002 م، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
65 ـ التفسير الصافي، محسن الفيض الكاشاني، (ت 1091ﻫ) تحقيق الشيخ حسين الأعلمي الطبعة الثالثة 1416ﻫ ، مطبعة مؤسسة الهادي، قم المقدّسة، منشورات مكتبه الصدر، طهران ـ إيران.
66 ـ تفسير العيّاشي، أبو النضر، محمّد بن مسعود بن عيّاش السّلمي، السمرقندي (ت320ﻫ) تحقيق الحاج هاشم الرسولي المحلاتي، المكتبة العلمية الإسلامية طهران.
67 ـ تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت 671ﻫ) تحقيق أحمد بن العليم البردوني، منشورات دار إحياء التُّراث العربي، بيروت ـ لبنان.
68 ـ تفسير القمّي، عليّ بن إبراهيم القمّي، (ت 329ﻫ) تصحيح وتعليق وتقديم السيد طيّب الموسوي الجزائري، مطبعة النجف الأشرف 1387ﻫ ، منشورات مكتبه الهدى.
69 ـ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، فخر الدين الرازي (ت 606ﻫ)، الطبعة الثالثة، المطبعة البهيّة المصرية.
70 ـ تفسير الكشّاف، الزمخشري (ت 538ﻫ) سنة الطبع 1385ﻫ ـ 1966 م منشورات شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده بمصر.
71 ـ تفسير الميزان، العلّامة الطباطبائي، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة ـ قم المقدّسة.
72 ـ تفسير فرات الكوفي، أبو القاسم، فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي (ت 352ﻫ) تحقيق محمّد الكاظم، الطبعة الأُولى 1410ﻫ ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
73 ـ تفسير كنز الدقائق، الميرزا محمد المشهدي (ت 1125ﻫ) تحقيق مجتبى العراقي، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين، 1407ﻫ ، قم المقدّسة.
74 ـ تفسير مجمع البيان، أمين الإسلام الطبرسي (ت 560ﻫ) تحقيق لجنة من العلماء، الطبعة الأُولى 1415ﻫ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
75 ـ تفسير نور الثقلين، الشيخ عبد علي العروسي الحويزي (ت 1112ﻫ) تحقيق السيد هاشم الرسولي المحلاتي، الطعبة الرابعة 1412ﻫ ، مؤسسة إسماعيليان، قم المقدّسة.
76 ـ تنبيه الخواطر (مجموعة ورّام)، أبو الحسين، ورّام بن أبي فراس المالكي الأشتري (ت 605ﻫ)، منشورات مكتبة الفقيه، قم ـ إيران.
77 ـ تنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات، محبّ الدين الأفندي (ت 1016ﻫ)، منشورات مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده.
78 ـ تنزيه الأنبياء، السيد المرتضى علم الهدى (ت 436ﻫ)، الطبعة الثانية 1409ﻫ ـ 1989م، منشورات دار الأضواء، بيروت ـ لبنان.
79 ـ تهذيب الأحكام، الطوسي، محمد بن الحسن، (ت 460ﻫ)، المطبعة خورشيد، الطبعة الرابعة 1365 ش، دار الكتب الإسلامية،.
80 ـ تهذيب التهذيب، شهاب الدين، ابن حجر العسقلاني (ت 852ﻫ)، الطبعة الأُولى 1404ﻫ ـ 1984 م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
81 ـ تهذيب الكمال، جمال الدين المزّي (ت 742ﻫ) تحقيق الدكتور بشّار عوّاد معروف، الطبعة الرابعة 1406ﻫ ـ 1985 م، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان.
82 ـ التوحيد، الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي (381ﻫ)، تحقيق السيد هاشم الحسيني الطهراني، سنة الطبع 1387ﻫ من منشورات جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
ـ حرف الثاء ـ
83 ـ ثمرات الأعوّاد، السيد علي بن الحسين الهاشمي النجفي (ت 1396ﻫ)، الطعبة الأُولى 1420ﻫ ، منشورات المكتبة الحيدريّة، قم المقدّسة.
84 ـ ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، (ت 381ﻫ) المطبعة أمير، قم، الطبعة الثانية 1368 ش، منشورات الشريف الرضي.
ـ حرف الجيم ـ
85 ـ جامع أحاديث الشيعة، السيد حسين البروجردي (ت 1383ﻫ)، المطبعة العلمية 1399ﻫ ، قم المقدّسة.
86 ـ جامع السعادات، محمد مهدي النراقي (ت 1209ﻫ) تحقيق وتعليق السيّد محمد كلانتر، تقديم الشيخ محّمد رضا المظفّر، الطبعة الرابعة، مطبعة النعمان، النجف الأشرف.
88 ـ الجامع الصغير، جلال الدين السيوطي (ت 911ﻫ) الطبعة الأُولى 1401ﻫ 1981 م، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
89 ـ جامع المقاصد، المحقّق الكركي (ت 940ﻫ)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الأُولى 1408ﻫ ، قم المقدّسة.
90 ـ الجَمل، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت 413ﻫ)، مكتبة الداوري، قم ـ إيران.
91 ـ جواهر المطالب، محمد بن أحمد الدمشقي الشافعي (ت 871ﻫ)، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، الطبعة الأُولى 1415ﻫ ، منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم المقدّسة.
ـ حرف الحاء ـ
92 ـ الحدائق الناضرة، الشيخ يوسف البحراني (ت 1186ﻫ)، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المقدسة.
93 ـ حقيقة علم آل محمد وجهاته، السيد عاشور (معاصر) مجهولة.
94 ـ حلية الأبرار، السيد هاشم البحراني (ت 1107)، تحقيق الشيخ غلام الرضا البروجردي، الطبعة الأُولى 1411ﻫ ، منشورات مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
ـ حرف الخاء ـ
95 ـ الخرائج والجرائح، قُطب الدين الراوندي، (ت 573ﻫ) تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي×، قم المقدّسة.
96 ـ خزانة الأدب، البغدادي (ت 1093ﻫ) تحقيق محمد نبي طريفي، إميل بديع يعقوب، الطبعة الأُولى 1998 م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
97 ـ الخصال، الشيخ الصدوق (ت381ﻫ) تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، 1403ﻫ ، قم المقدّسة.
98 ـ خصائص الأئمّة، الشريف الرضي (ت 406ﻫ)، تحقيق محمد هادي الأميني منشورات مجمع البحوث الإسلامية. الأستانة الرضوية المقدّسة، مشهد ـ إيران.
99 ـ الخصائص العبّاسية، الحاج محمد إبراهيم الكلباسي، الطبعة الأُولى 1378 ش ـ 1420ﻫ ، انتشارات المكتبة الحيدرية، قم المقدّسة.
100 ـ خصائص الوحي المبين، ابن البطريق، يحيى بن الحسن الأسدي (ت 600ﻫ)، تحقيق الشيخ مالك المحمودي، الطبعة الأولى 1417ﻫ، منشورات دار القرآن.
ـ حرف الدال ـ
101 ـ الدرّ النضيد، السيد محسن الأمين (ت1371ﻫ)، الطبعة الأُولى 1378ش، منشورات الشريف الرضي، قم المقدّسة.
102 ـ الدرُّ النظيم، ابن حاتم العاملي (ت 664ﻫ)، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
103 ـ الدرجات الرفيعة، السيد علي خان المدني (ت 1120ﻫ)، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، منشورات مكتبة بصيرتي، 1397ﻫ ، قم المقدّسة.
104 ـ الدروع الواقية، السيّد ابن طاووس (ت 664ﻫ)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة، سنة 1414ﻫ .
105 ـ دعائم الإسلام، القاضي النعمان المصري (ت 363ﻫ)، تحقيق آصف بن علي أصغر فيضي، منشورات دار المعارف القاهرة 1963 م.
106 ـ دلائل الإمامة، الشيخ الطبري الإمامي المتوفّي أوائل القرن الرابع الهجري، الطبعة الأُولى 1413ﻫ، مؤسسة البعثة، قم المقدّسة.
108 ـ ديوان دعبل الخزاعي، دعبل بن عليّ الخزاعي (ت 246ﻫ) الطبعة الأُولى، 1417ﻫ ـ 1997م، مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان.
109 ـ ديوان سيد رضا الهندي، السيد رضا الموسوي الهندي (ت 1362ﻫ)، تحقيق السيد موسى الموسوي، مراجعة وتعليق السيد عبد الصاحب الموسوي، الطبعة الأُولى 1409ﻫ ـ 1988م، منشورات دار الأضواء، بيروت ـ لبنان.
110 ـ ديوان مفاتيح الدموع، الشيخ محمد سعيد المنصوري (ت 1428ﻫ)، الطبعة الأُولى 1410ﻫ ، الناشر ولده المرحوم عبد الحسين المنصوري.
111 ـ ديوان ميراث المنبر، الشيخ محمد سعيد المنصوري (ت 1428ﻫ)، طبع ونشر دار المنصوري، الطبعة الأُولى 1423ﻫ .
ـ حرف الذال ـ
112ـ ذوب النضار، ابن نما الحلّي (ت 645ﻫ)، تحقيق فارس حسّون كريم، الطبعة الأُولى 1416ﻫ، مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
ـ حرف الراء ـ
113 ـ رسائل الشهيد الثاني، الشيخ زين الدين الجبعي العاملي (ت 966ﻫ)، الطبعة الحجرية، منشورات مكتبة بصيرتي، قم المقدّسة.
114 ـ الركب الحسيني، مجموعة (معاصرة) الطبعة الثانية 1425ﻫ ، إعداد ونشر مركز الدراسات الإسلامية ممثليّة الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية، قم المقدّسة.
115 ـ روضة الواعظين، محمّد بن الفتّال النيسابوري، (ت508ﻫ)، تحقيق السيد محمد مهدي الخرسان، منشورات الشريف الرضي، قم المقدّسة.
116 ـ رياض السالكين، السيد علي خان المدني الشيرازي (ت 1120ﻫ)، تحقيق السيد محسن الحسيني الأميني، الطبعة الرابعة 1415ﻫ ، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة.
117 ـ رياض المدح والرثاء، الشيخ حسين علي آل الشيخ سليمان البلادي البحراني، تصحيح وتعليق حسن عبد الأمير، انتشارات المكتبة الحيدريّة، قم المقدّسة، الطبعة الرابعة 1426ﻫ .
ـ حرف الزاي ـ
118 ـ زهر الربيع، السيد نعمة الله الجزائري (ت 1112ﻫ) مجهولة.
ـ حرف السين ـ
119 ـ سر السلسلة العلوية، أبو نصر البخاري (ت 341ﻫ)، تحقيق السيد محمّد صادق بحر العلوم الطبعة الأُولى 1413ﻫ ـ 1371 ش، انتشارات الشريف الرضي، قم المقدّسة.
120 ـ سفير الحسين مسلم بن عقيل×، العلّامة الشيخ عبد الواحد المظفّر الطبعة الثالثة 1388ﻫ ـ 1968 م، مطبعة الآداب في النجف الأشرف.
121 ـ سفينة البحار، الشيخ عباس القمي (ت 1359ﻫ) مطبعة دار الأُسوة، الطبعة الثانية 1416ﻫ ، قم المقدّسة.
122 ـ سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني (ت 273ﻫ)، تحقيق وترقيم وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي، منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
123 ـ سنن أبي داوود، أبو داوود، ابن الأشعث السجستاني (ت 275ﻫ)، تحقيق سعيد محمّد اللَّحام، الطبعة الأُولى 1410ﻫ ـ 1990م، منشورات دار الفكر.
124 ـ سنن الترمذي، الترمذي (ت 279ﻫ)، تحقيق وتصحيح عبد الوهّاب عبد اللطيف، الطبعة الثانية 1403ﻫ ـ 1983 م، منشورات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
126 ـ السنن الكبرى، النسائي (ت 303ﻫ)، تحقيق عبد الغفّار سليمان البغدادي، سيد كسروي حسن، الطبعة الأُولى 1411ﻫ ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
127 ـ سنن النبيّ، العلّامة الطباطبائي، محمد حسين (ت 1402ﻫ)، تحقيق الشيخ محمّد هادي الفقهي، 1419ﻫ ، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي.
128 ـ سياسة الحسين، الشيخ عبد العظيم الربيعي (ت 1399ﻫ)، الطبعة الأُولى 1420ﻫ ، منشورات المكتبة الحيدريّة، قم المقدّسة.
129 ـ سير أعلام النبلاء، الذهبي (ت 748ﻫ)، تحقيق العرقسوسي، ثامون صاغرجي، الطبعة التاسعة 1413ﻫ ، منشورات الرسالة، بيروت ـ لبنان.
130 ـ سيرة الأئمّة، الشيخ مهدي البيشوائي (معاصر) تعريب حسين الواسطي، طباعة ونشر مؤسسة الإمام الصادق×، تقديم الشيخ جعفر السبحاني.
131 ـ السيرة الحلبية، الحلبي (ت 1044ﻫ) منشورات دار المعرفة1400ﻫ ، بيروت ـ لبنان.
132 ـ السيرة النبوية (ابن كثير)، أبو الفداء إسماعيل بن كثير (747ﻫ)، تحقيق مصطفى عبد الواحد، منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 1976م، بيروت ـ لبنان.
ـ حرف الشين ـ
133 ـ الشافي في الإمامة، السيد مرتضى علم الهدى (ت 436ﻫ) الطبعة الثانية 1410ﻫ، منشورات مؤسسة إسماعيليان، قم المقدّسة.
134 ـ شجرة طوبى، الشيخ محمد مهدي الحائري (ت 1369ﻫ)، الطبعة الخامسة 1385ﻫ ، منشورات المكتبة الحيدريّة ومطبعتها، النجف الأشرف.
135 ـ شرح إحقاق الحقّ، السيد المرعشي، (ت1411ﻫ) تصحيح السيد إبراهيم الميانجي، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم المقدّسة.
136 ـ شرح أُصول الكافي، المولى محمد صالح المازندراني (ت 1081ﻫ).
137 ـ شرح الأخبار، النعمان بن مُحمّد التميمي، (ت 363ﻫ)، تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة.
138 ـ شرح التجريد، العلّامة الحلّي (ت 726ﻫ)، تحقيق الشيخ حسن زاده آملي، الطبعة السابعة 1417ﻫ ، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة.
139 ـ شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الاسترآبادي (ت 686ﻫ)، تحقيق يوسف حسن عمر، مشورات مؤسسة الصادق 1395ﻫ ـ 1975م ـ طهران.
140 ـ الشرح الكبير، عبد الرحمن بن قدامة (ت 682ﻫ) الطبعة الجديدة بالأوفست، منشورات دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
141 ـ شرح رسالة الحقوق، السيد حسن القبانچي[725] منشورات دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
142 ـ شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين×، كمال الدين، ميثم بن علي البحراني (ت 679ﻫ)، تحقيق مير جلال الدين الحسيني الأرموي المحدّث، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، قم المقدّسة.
143 ـ شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 656ﻫ)، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، منشورات المرعشي النجفي، إنتشارات دار إحياء الكتب العربية.
144 ـ الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد، محاضرات الشيخ محمد السند، بقلم السيد رياض الموسوي، الطبعة الأُولى، منشورات دار الغدير 1424ﻫ ، قم المقدّسة.
145 ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى، القاضي أبو الفضل عيّاض اليحصبي (ت 544ﻫ)، دار الفكر 1409 ـ 1988 م، بيروت ـ لبنان.
ـ حرف الصاد ـ
146 ـ صحيح ابن حبّان، ابن حبّان (ت 354ﻫ) تحقيق شعيب الأرنؤوط، الطبعة الثانية 1414ﻫ ـ 1993م، منشورات مؤسسة الرسالة.
147 ـ صحيح ابن خزيمة، أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت 211ﻫ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية 1412ﻫ ـ 1992م، منشورات المكتب الإسلامي.
148 ـ صحيح البخاري، البخاري، (ت 256ﻫ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع سنة 1401ﻫ ـ 1981 م.
149 ـ صحيح مسلم، مسلم النيسابوري (ت 261ﻫ)، دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
ـ حرف الطاء ـ
150 ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، السيد ابن طاووس (ت 664ﻫ)، الطبعة الأُولى 1399ﻫ، المطبعة خيام، قم المقدّسة.
ـ حرف العين ـ
151 ـ عدّة الداعي، أحمد بن فهد الحلّي (ت 841ﻫ)، تحقيق أحمد الموحّدي القمّي، منشورات مكتبة الوجداني، قم المقدّسة.
152 ـ العروة الوثقى، السيد محمد كاظم اليزدي (ت 1337ﻫ) تحقيق ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولى 1417ﻫ ، قم المقدّسة.
153 ـ العقلية زينب والفواطم، الحاج حسين الشاكري (ت 1430ﻫ)، الطبعة الأُولى 1422ﻫ ـ 2001 م منشورات المؤسسة الإسلامية للتبليغ والإرشاد، قم المقدّسة.
154 ـ علل الترمذي، محمّد بن سورة (ت 279ﻫ)، الطبعة الثانية 1403ﻫ ، طباعة ونشر دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
155 ـ علل الشرائع، الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي (ت 381ﻫ)، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية 1386ﻫ ـ 1966م، النجف الأشرف.
156 ـ عمدة الطالب، جمال الدين، أحمد بن علي المعروف بابن عنبة (ت 828ﻫ)، تحقيق محمد حسن آل الطالقاني، الطبعة الثانية 1380ﻫ ـ 1961م منشورات المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف.
157 ـ عمدة القارئ، العيني، (ت 855ﻫ)، مطبعة ونشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
158 ـ العمدة، ابن البطريق، يحيى بن الحسن الأسدي (ت 600ﻫ)، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي1407ﻫ ، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
159 ـ العوالم، الشيخ عبد الله البحراني (ت1130ﻫ)، تحقيق مدرسة الإمام المهدي#، الطبعة الأُولى 1407ﻫ ، قم المقدّسة.
160 ـ عوالي اللئالي، ابن أبي جمهور الإحسائي (ت 880ﻫ)، تحقيق آقا مجتبى العراقي، الطبعة الأُولى 1403ﻫ ـ 1983م.
161 ـ عين الحياة، العلّامة المجلسي، محمّد باقر (ت 1111ﻫ)، ترجمة وتحقيق السيّد هاشم الميلاني، الطبعة الأُولى 1416ﻫ، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدّسة.
162 ـ العين، الفراهيدي، الخليل بن أحمد (ت 170ﻫ)، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، الطبعة الثانية 1409ﻫ ، مؤسسة دار الهجرة.
163 ـ عيون أخبار الرضا، الشيخ الصدوق (ت 381ﻫ)، تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، الطبعة الأُولى 1404ﻫ، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان.
164 ـ عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الكليني الواسطي، المتوفّى في القرن السادس الهجري، تحقيق الشيخ حسين الحسيني البيرجندي، الطبعة الأُولى منشورات دار الحديث.
165 ـ عيون المعجزات، الشيخ حسين بن عبد الوهّاب، المتوفّي في القرن الخامس هجري، تاريخ النشر 1369ﻫ ، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف.
ـ حرف الغين ـ
166 ـ الغارات، إبراهيم بن محمد الثقفي (ت 283ﻫ)، تحقيق السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدّث.
167 ـ غاية المرام، السيد هاشم البحراني (ت 1107ﻫ)، تحقيق السيد عاشور.
168 ـ الغدير، الشيخ عبد الحسين الأميني (ت 1392ﻫ)، الطبعة الرابعة 1397ﻫ ـ 1977م، منشورات دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
169 ـ غرر الحكم، الشيخ أبو الفتح عبد الواحد بن محمّد بن عبد الواحد الآمدي الإمامي (ت 510ﻫ) مجهولة.
ـ حرف الفاء ـ
170 ـ الفايق في غريب الحديث، جار الله الزمخشري، (ت 538ﻫ)، الطبعة الأُولى 1417ﻫ ـ 1996م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
171 ـ فتح الباري، ابن حجر، شهاب الدين العسقلاني (ت 852ﻫ)، الطبعة الثانية، طباعة ونشر دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.
172 ـ فرج المهموم، السيد ابن طاووس (ت 664ﻫ)، منشورات الشريف الرضي، سنة الطبع 1363 ش، قم المقدّسة.
173 ـ فرحة الغري، السيّد عبد الكريم بن طاووس الحسيني، (ت 693ﻫ)، تحقيق السيد تحسين آل شبيب الموسوي، الطبعة الأُولى 1419ﻫ ، مركز الغدير للدراسات الإسلامية.
174 ـ الفصول المختارة، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان العكبري البغدادي (413ﻫ) الطبعة الثانية 1414ﻫ ، تحقيق السيد علي مير شريفي، منشورات دار المفيد.
175 ـ الفصول المهمّة في أصول الأئمّة، الحرّ العاملي، (ت 1104ﻫ)، تحقيق وإشراف محمّد القائيني، الطبعة الأُولى 1418ﻫ ، منشورات مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا×.
176 ـ الفصول المُهمّة في معرفة الأئمّة، ابن الصبّاغ المالكي (ت 855ﻫ)، تحقيق الشيخ سامي الغريري، الطبعة الأُولى 1422ﻫ ، منشورات دار الحديث للطباعة والنشر.
177 ـ فضائل الشيعة، الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه القمّي (ت 381ﻫ)، منشورات كانون عابدي، طهران ـ إيران.
178 ـ فضائل الصحابة، النسائي، أبو عبد الرحمن، أحمد بن شعيب (ت 303ﻫ)، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
179 ـ فقه الإمام جعفر الصادق، الشيخ محمد جواد مغنية (ت 1308ﻫ)، الطبعة الرابعة 1402ﻫ ، دار الجواد، منشورات دار التعارف، بيروت ـ لبنان.
180 ـ فقه القرآن (الراوندي) قطب الدين، سعيد بن هبة الله الراوندي (ت 573ﻫ)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، الطبعة الثانية 1405ﻫ ، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم المقدّسة.
181 ـ فهرست منتجب الدين، الشيخ منتجب الدين ابن بابويه، (ت 585ﻫ)، تحقيق السيد جلال الدين محدّث الأرموي، منشورات مكتبة المرعشي النجفي، قم المقدّسة.
ـ حرف القاف ـ
182 ـ القاموس المحيط، الفيروزآبادي (ت 817ﻫ) مجهولة.
183 ـ قرب الإسناد، الحميري، القُمّيّ (ت 300ﻫ)، الطبعة الأُولى 1413ﻫ ، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة.
184 ـ قصص الأنبياء (الجزائري)، السيد نعمة الله الجزائري (ت1112ﻫ)، منشورات الشريف الرضي، قم المقدّسة.
185 ـ قصص الأنبياء (الراوندي)، قطب الدين، سعيد بن هبة الله الراوندي (ت 573ﻫ)، تحقيق غلام رضا عرفانيان، الطبعة الأُولى 1418ﻫ ـ 1376ش، منشورات الهادي.
ـ حرف الكاف ـ
186 ـ الكافي، الكُليني، محمّد بن يعقوب (ت 329ﻫ) تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، الطبعة الخامسة (1363 ش)، الناشر دار الكُتب الإسلامية، طهران ـ إيران.
187 ـ كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولوية، (ت 367ﻫ)، تحقيق الشيخ جواد القيومي الطبعة الأُولى 1417ﻫ ، جماعة المدرّسين، منشورات مؤسسة الفقاهة.
188 ـ الكامل في التاريخ، ابن الأثير (ت 630ﻫ)، منشورات دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 1386ﻫ ـ 1966م.
189 ـ الكامل، ابن عدي الجرجاني (ت 365ﻫ)، تحقيق يحيى مختار عزاوي، الطبعة الثالثة 1409ﻫ ـ 1988 م، منشورات دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
190 ـ كتاب الزُّهد، الحسين بن سعيد الكوفي، المُتوفّى في القرن الثالث الهجري، تحقيق ميرزا غلام رضا عرفانيان، المطبعة العلمية ،1399ﻫ ، قم المقدّسة.
191 ـ كتاب الفتوح، ابن أعثم الكوفي، (ت 314ﻫ) تحقيق عليّ شيري، الطبعة الأُولى سنة 1411ﻫ طباعة ونشر دار الأضواء، بيروت ـ لبنان.
192 ـ كتاب سليم بن قيس، أبو صادق، سليم بن قيس الهلالي (ت 76ﻫ)، تحقيق محمد باقر الأنصاري، غير مؤرّخة.
193 ـ كشف الخفاء، العجلوني، إسماعيل بن محمّد (ت 1162ﻫ) الطبعة الثالثة 1408ﻫ ـ 1988م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
194 ـ كفاية الأثر، الخزّاز القمّي (ت 400ﻫ) تحقيق السيد عبد اللطيف الحسيني الكوهكمري الخوئي، المطبعة خيّام، منشورات بيدارـ قم المقدّسة.
195 ـ الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء، السيد عبد الحسين شرف الدين (ت 1337ﻫ)، مطبوعة في دار النعمان في النجف الأشرف في ذيل الفصول المهمّة في تأليف الأُمّة له&.
196 ـ كمال الدين وتمام النعمة، الشّيخ الصّدوق (ت 381ﻫ)، تحقيق علي أكبر الغفاري منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرسين، قم المقدّسة.
197 ـ كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي (ت 449ﻫ)، الطبعة الثانية 1369 ش، منشورات المكتبة الحيدرية، قم المقدّسة.
198 ـ كيمياء المحبّة، سيرة رجب علي الخيّاط بقلم الشيخ محمد الريشهري (معاصر).
ـ حرف اللام ـ
199 ـ لسان العرب، ابن منظور (ت 711ﻫ) 1405ﻫ ، نشر أدب الحوزة قم المقدّسة.
200 ـ اللهوف، السيد ابن طاووس (ت 664ﻫ)، الطبعة الأُولى 1417ﻫ ، منشورات أنوار الهدى، قم المقدّسة.
201 ـ لواعج الأشجان، السيد محسن الأمين (ت 1371ﻫ)، مطبعة العرفان صيدا 1331ﻫ ، منشورات مكتبة بصيرتي، قم المقدّسة.
ـ حرف الميم ـ
202 ـ مثير الأحزان، ابن نما الحلّي، (ت 645ﻫ)، المطبعة الحيدرية 1369ﻫ ـ 1950م، النجف الأشرف.
203 ـ مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحي (ت 1085ﻫ)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، الطبعة الثانية 1408ﻫ ، مكتبة نشر الثقافة الإسلامية.
204 ـ مجمع الزوائد، الهيثمي، (ت 807ﻫ) دار الكتب العلمية، سنة 1408ﻫ ـ 1988م، بيروت ـ لبنان.
205 ـ مجمع الشعراء، كامل سليمان الجبوري، منشورات محمّد عليّ بيضون الطبعة الأولى 1424ﻫ ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
206 ـ مجمع الفائدة والبرهان، المقدّس الأردبيلي (ت993ﻫ)، تحقيق مجتبى العراقي، الشيخ علي پناه الاشتهاردي، حسين اليزدي، منشورات جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
207 ـ مجمع مصائب أهل البيت^، الشيخ محمد الهنداوي، معاصر، الطبعة الأولى 1425ﻫ، إنتشارات المكتبة الحيدرية.
208 ـ المجموع، محي الدين النووي (ت 676ﻫ)، منشورات دار الفكر.
209 ـ مجموعة رسائل، الشيخ لطف الصافي الگلپايگاني، معاصر.
210 ـ مجموعة ورّام (تنبيه الخواطر ونزهة النواظر)، أبو الحسن ورّام بن أبي فراس المالكي الأشتري، (ت 605ﻫ)، منشورات مكتبة الفقيه، قم المقدّسة.
211 ـ المحاسن ، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (ت 247ﻫ)، تحقيق وتعليق السيد جلال الدين الحسيني (المحدّث)، الناشر دار الكتب الإسلامية1370ﻫ ، طهران.
212 ـ محاضرات في الإلهيات، الشيخ جعفر السبحاني، معاصر، مؤسسة الإمام الصادق× قم المقدّسة.
213 ـ المحجّة البيضاء، الملا محسن الفيض الكاشاني (ت 1091ﻫ) منشورات جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
213 ـ المحلّى، ابن حزم (ت 456ﻫ) منشورات دار الفكر.
214ـ الإمامة والتبصرة، ابن بابويه القُمّي والد الشيخ الصدوق، (ت 329ﻫ)، تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي#، قم المقدّسة.
214 ـ مدينة المعاجز، السيد هاشم البحراني (ت 1107ﻫ)، تحقيق الشيخ عزة الله الهمداني، الطبعة الأُولى 1413ﻫ ، منشورات مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
215 ـ مرآة العقول، العلّامة المجلسي (ت 1111ﻫ) مجهولة.
216 ـ المزار (ابن المشهدي)، الشيخ محمد بن المشهدي (ت 610ﻫ)، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني الطبعة الأُولى 1419ﻫ ، منشورات القيوم، قم المقدّسة.
217 ـ المزار (الشيخ المفيد)، محمد بن النُّعمان المفيد، (ت 413ﻫ)، تحقيق السيد محمّد باقر الأبطحي، الطبعة الثانية 1414ﻫ ، منشورات دار المفيد، بيروت ـ لبنان.
218 ـ مسارّ الشيعة، الشيخ المفيد (ت 413ﻫ)، تحقيق الشيخ مهدي نجف، الطبعة الثانية 1414ﻫ ـ 1993م، منشورات دار المفيد، بيروت ـ لبنان.
219 ـ مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، (ت 1320ﻫ)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^، بيروت ـ لبنان.
20 2 ـ المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، (ت 405ﻫ)، تحقيق وإشراف يوسف عبد الرحمن المرعشلي.
221 ـ مستطرفات السرائر، ابن إدريس الحلّي (ت 598ﻫ)، تحقيق ونشر لجنة التحقيق في مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، الطبعة الثانية 1411ﻫ ، قم المقدّسة.
222 ـ مستند الشيعة، المولى أحمد النراقي (ت 1244ﻫ)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، الطبعة الأُولى 1415ﻫ ، مشهد المقدّسة.
223 ـ مسكّن الفؤاد، الشهيد الثاني (المستشهد سنة 966ﻫ)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث الطبعة الأُولى ، قم المقدّسة.
224 ـ مسند ابن راهويه، إسحاق ابن راهويه (ت 238ﻫ) تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحقّ حسين برد البلوسي، الطبعة الأُولى 1412ﻫ ، مكتبة الإيمان، المدينة المنوّرة.
225 ـ مسند أحمد، أحمد بن حنبل (ت 241ﻫ) دار صادر، بيروت ـ لبنان.
226 ـ مسند الشهاب، ابن سلامة، (ت 454ﻫ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأُولى 1405ﻫ ـ 1985 م، منشورات مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان.
227 ـ مسند زيد بن عليّ، زيد بن علي÷ (ت 122ﻫ)، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان.
228 ـ مشكاة الأنوار، علي الطبرسي، تحقيق مهدي هوشمند، الطبعة الأُولى 1418ﻫ ، منشورات دار الحديث.
229 ـ المصباح (الكفعمي)، الشيخ تقي الدين إبراهيم، الكفعمي (ت 905ﻫ) الطبعة الثالثة 1403ﻫ ـ 1983 م، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان.
230 ـ مصباح المتهجّد، الشيخ الطوسي (ت 460ﻫ) الطبعة الأُولى 1411ﻫ ـ 199م منشورات مؤسسة فقه الشيعة، بيروت ـ لبنان.
231 ـ المصنّف، ابن أبي شيبة الكوفي (ت 235ﻫ) تحقيق سعيد اللّحام، الطبعة الأُولى 1409ﻫ ـ 1989 م، منشورات دار الفكر، بيروت ـ لبنان.
232 ـ معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول، الزرندي الشافعي (ت 750ﻫ)، تحقيق ماجد بن أحمد العطية.
233 ـ معالي السبطين، الشيخ محمد مهدي الحائري (ت 1369ﻫ)، منشورات المكتبة الحيدرية والشريف الرضي، قم المقدّسة.
234 ـ معاني الأخبار، الشيخ الصدوق (ت 381ﻫ) تصحيح وتعليق عليّ أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة 1379ﻫ..
235 ـ المعجم الأوسط، الحافظ الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد (ت 360ﻫ)، تحقيق ونشر قسم التحقيق بدار الحرمين 1415ﻫ ـ 1995م.
236 ـ معجم البلدان، ياقوت الحموي (ت 626ﻫ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان.
237 ـ المعجم الكبير، الطبراني، (ت 360ﻫ)، تحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية، منشورات دار إحياء التراث العربي، تحقيق السيد أحمد الحسيني.
238 ـ معجم رجال الحديث، السيد أبو القاسم الخوئي (ت 1413ﻫ)، الطبعة الخامسة 1413ﻫ ـ 1992م، طبعة منقحة ومزيدة.
239 ـ معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا (ت 395ﻫ) تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الإعلام الإسلامي 1404ﻫ .
240 ـ معدن الجواهر، أبو الفتح بن علي الكراجكي (ت 449ﻫ)، تحقيق السيد أحمد الحسيني، الطبعة الثانية 1394ﻫ .
241 ـ مغني اللبيب، ابن هشام الأنصاري (ت 761ﻫ)، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد منشورات مكتبة آية الله العظمي المرعشي النجفي 1404ﻫ ، قم المقدّسة.
242 ـ المغني، ابن قُدامة، عبد الله (ت 620ﻫ)، منشورات دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
243 ـ مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القُمّي (ت 1359ﻫ)، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
244 ـ مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني (ت 502ﻫ)، الطبعة الثانية 1404ﻫ ، منشورات دفتر نشر الكتاب.
245 ـ مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني (ت 356ﻫ) الطبعة الثانية 1385ﻫ ـ 1965 م، منشورات المكتب الحيدرية ومطبعتُها، النجف الأشرف.
246 ـ مقتل الإمام الحسين (أبو مخنف)، لوط بن يحيى، أبو مخنف الأزدي (ت 157ﻫ) تحقيق حسين الغفاري، المطبعة العلمية، قم المقدّسة.
247 ـ مقتل الحسين (المقرّم) العلامة السّيد عبد الرزّاق المقرّم (ت1391ﻫ)، الطبعة الأُولى 1414ﻫ 1372 ش، منشورات الشريف الرضي، قم المقدّسة.
248 ـ المقنعة، الشيخ المفيد، محمد بن النعمان البغدادي العكبري (ت 413ﻫ)، الطبعة الثانية 1410ﻫ مؤسسة النشر الإٍسلامي، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
249 ـ مكارم الأخلاق، الطبرسي، الحسن بن الفضل (ت 548ﻫ)، الطبعة السادسة 1392ﻫ ـ 1972م، منشورات الشريف الرضي، قم المقدّسة.
250 ـ مكارم الأخلاق (ابن أبي الدنيا)، ابن أبي الدنيا (ت281ﻫ)، تحقيق مجدي السيد إبراهيم، منشورات مكتبة القرآن، القاهرة.
251 ـ مكارم الأخلاق، الشيخ الطبرسي، (ت 548ﻫ) الطبعة السادسة 1392ﻫ ـ 1972م منشورات الشريف الرضي.
252 ـ الملاحم والفتن، السيد ابن طاووس (ت 664ﻫ)، الطبعة الأُولى 1416ﻫ منشورات صاحب الأمر#.
253 ـ من أخلاق الإمام الحسين، عبد العظيم المهتدي البحراني( معاصر)، الطبعة الأُولى 1421ﻫ ـ 2000 م، انتشارات الشريف الرضي، قم المقدّسة.
254ـ مَن لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق (ت 381ﻫ)، تحقيق علي أكبر الغفاري، الطبعة الثانية، منشورات مؤسسة جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
255 ـ المناقب (مناقب الخوارزمي)، الموفّق الخوارزمي (ت 568ﻫ) تحقيق الشيخ مالك المحمودي، الطبعة الثانية 1414ﻫ ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
256 ـ مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب (ت 588ﻫ) تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف سنة الطبع 1376ﻫ ـ 1956 م، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف.
257 ـ مناقب الإمام أمير المؤمنين×، محمد بن سليمان الكوفي من أعلام القرن الثالث، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، الطبعة الأُولى 1412ﻫ مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم المقدّسة.
258 ـ المنتخب، الشيخ فخر الدين الطريحي (ت 1085ﻫ)، الطبعة الثالثة 1422ﻫ ، منشورات الشريف الرضي، قم المقدّسة.
259 ـ منتهى الآمال، الشيخ عبّاس القمّي (ت 1359ﻫ)، ترجمة السيد هاشم الميلاني، منشورات مؤسسة النشر الإسلامي، جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
260 ـ منتهى المطلب، العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف بن المطهّر (ت 726ﻫ) تحقيق قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الأُولى 1412ﻫ، منشورات مجمع البحوث الإسلامية، مشهد المقدّسة.
261 ـ منهاج الصالحين، السيد أبو القاسم الخوئي (1413ﻫ)، الطبعة الثانية والعشرون 1410ﻫ، منشورات مدينة العلم آية الله الخوئي، قم المقدّسة.
262 ـ مواقف الشيعة، الأحمدي الميانجي، الطبعة الأُولى 1416ﻫ، مؤسسة النشر الإٍسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
263 ـ المواقف، الأيجي (ت 756ﻫ) تحقيق عبد الرحمن عميرة، الطبعة الأُولى 1417ﻫ ـ 1997م، منشورات دار الجيل، بيروت ـ لبنان.
264 ـ موسوعة كلمات الإمام الحسين، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، الطبعة الثالثة 1416ﻫ ـ 1995 م، دار المعروف للطباعة والنشر.
ـ حرف النون ـ
265 ـ النزاع والتخاصم، تقي الدين، أحمد بن علي المقريزي (ت 845ﻫ)، تحقيق السيد علي عاشور.
266 ـ نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، الحلواني، الحسين بن محمد بن الحسن المتوفى في القرن الخامس الهجري، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي# الطبعة الأُولى 1408ﻫ ، قم المقدّسة.
268 ـ النصّاريات الكبرى، الشّيخ مُحمّد بن نصّار، منشورات المكتبة الحيدريّة، قم المقدّسة.
269 ـ نظرة إلى حياة السيدة فاطمة المعصومة‘، انتشارات السيدة المعصومة‘، قم المقدّسة، بدون تاريخ.
270 ـ نظم درر السمطين، جمال الدين الزرندي الحنفي (ت 750ﻫ)، الطبعة الأُولى 1377ﻫ ـ 1958م.
271 ـ نهاية المرام، السيد محمد العاملي (ت 1009ﻫ)، تحقيق آغا مجتبى العراقي، علي پناه الاشتهاردي، آقا حسين اليزدي، الطبعة الأُولى 1413ﻫ ، منشورات جماعة المدرّسين، قم المقدّسة.
272 ـ النهاية في غريب الحديث، ابن الأثير، (ت 606ﻫ) تحقيق طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناجي، الطبعة الرابعة 1364 ش، منشورات مؤسسة إسماعيليان، قم المقدّسة.
273 ـ نهج الإيمان، ابن جبر، زين الدين، علي بن يوسف بن جبر من أعلام القرن السابع الهجري، تحقيق السيد أحمد الحسيني، الطبعة الأُولى 1418ﻫ ، منشورات مجمع الإمام الهادي#، مشهد المقدّسة.
274 ـ نهج السعادة، الشيخ المحمودي، معاصر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
275 ـ نوادر المعجزات، الشيخ الطبري الإمامي المتوفّى في القرن الرابع الهجري الطبعة الأُولى 1410ﻫ، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي×، قم المقدّسة.
ـ حرف الهاء ـ
276 ـ الهداية الكبرى، الحسين بن حمدان الخصيبي (ت 334ﻫ)، الطبعة الأُولى 1420ﻫ ، منشورات المكتبة الحيدرية، قم المقدّسة.
ـ حرف الواو ـ
277 ـ الوافي بالوفيات، الصفدي (ت 764ﻫ)، تحقيق أحمد الأرنأووط وتركي مصطفي، منشورات دار إحياء التراث1420ﻫ ـ 2000 م، بيروت ـ لبنان.
278 ـ وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، (ت1104ﻫ)، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الثانية 1414ﻫ ، المطبعة مهر، قم المقدّسة.
279 ـ وقعة صفّين، ابن مزاحم المنقري (ت 212ﻫ)، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الطبعة الثانية 1382ﻫ ، منشورات المؤسسة العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة.
ـ حرف الياء ـ
280 ـ يتيمة الدهر، الثعالبي، أبو منصور عبد الملك (ت429ﻫ)، تحقيق الدكتور مفيد محمّد قميحة، الطبعة الأُولى 1403ﻫ ـ 1983م، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
281 ـ ينابيع المعاجز، السيد هاشم البحراني (ت 1107ﻫ)، المطعبة العلميّة، قم المقدّسة.
282 ـ ينابيع المودّة، القندوزي (ت1294ﻫ) تحقيق السيد علي جمال أشرف، الطبعة الأُولى 1416ﻫ ، منشورات دار الأُسوة للطباعة والنشر.
[1] فضائل الصحابة: ص16.
[2] الكافي: ج2، ص355، ح5.
[3] الخصال: ص590 ـ 591، ح15.
[4] الخصال: ص592 ـ 593، ح19.
[5] رياض المدح والرثاء: ص728 ـ 730. ولم تُنسب لأحد، ولم أعثر على شاعرها، فللّه درّه، وعلى الله أجره.
[6] الحجّ: آية32.
[7] اُنظر: تاج العروس: ج3، ص304. كتاب العين: ج1، ص251. لسان العرب: ج4، ص414.
[8] البقرة: آية158.
[9] المائدة: آية2.
[10] الحج: آية32.
[11] الحج: آية36.
[12] الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: ص56 ـ 57. بتصرّف
[13]المائدة: آية2.
[14] تفسير العياشي: ج2، ص203.
[15] اُنظر: الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: ص134.
[16] مجمع الفائدة والبرهان: ج1، ص501.
[17] اُنظر: منتهى المطلب: ج2، ص998. إيضاح الفوائد: ج1، ص352، جامع المقاصد: ج3، ص374.
[18] المزار للشيخ المفيد: ص228. فرحة الغري: ص105. وسائل الشيعة: ج14، ص383، ضمن ح1.
[19] كامل الزيارات: ص492 ـ ص493، ح11. المزار للشيخ المفيد: ص225، ح7. تهذيب الأحكام: ج6، ص45، ح12. الدروع الواقية: ص73. وسائل الشيعة: ج14، ص429، ح3. بحار الأنوار: ج98، ص12، ح1، عن كامل الزيارات.
[20] كامل الزيارات: ص272، ح5، عنه بحار الأنوار: ج98، ص75، ح26.
[21] اُنظر: الشعائر الحسينية للسيد حسن الشيرازي: ص22 ـ 23.
[22] اُنظر: أمالي الشيخ الصدوق: ص190 ـ ص191، ح2، عنه إقبال الأعمال: ج3، ص28. روضة الواعظين: ص169. وسائل الشيعة: ج14، ص504 ـ ص505، ح8. بحار الأنوار: ج44، ص283 ـ 284، ح17، عن الأمالي.
[23] مستدرك الوسائل: ج10، ص318.
[24] كامل الزيارات: ص201 ـ ص202، ح2، عنه وسائل الشيعة: ج14، ص506 ـ 507، ح13. الفصول المهمّة في أصول الأئمّة: ج3، ص413، ح2. بحار الأنوار: ج44، ص291، ح32، عن كامل الزيارات أيضاً.
[25] عيون أخبار الرضا×: ج1، ص264، ح48. أمالي الشيخ الصدوق: ص131، ح4. وسائل الشيعة: ج14، ص502، ح4، عن العيون والأمالي. بحار الأنوار: ج1، ص200، ح6، عن العيون، و ج44، ص278، ح1، عن الأمالي.
[26] اُنظر: الشعائر الحسينية للسيد حسن الشيرازي: ص51 ـ 52.
[27] الأنوار القدسيّة: ص128.
[28] القصيدة من نظم الخطيب الأديب المرحوم الشيخ كاظم السّبتي&. قال عنه السيد محسن الأمين&: ـ في أعيان الشيعة: ج9، ص5 ـ الشيخ كاظم بن حسن بن علي سبتي البغدادي النجفي المعروف بالشيخ كاظم السبتي، ولد في حدود سنة (1255هـ)، وتوفي سنة (1342هـ) في النجف ودفن بها.
عالمٌ، فاضل، أديب، شاعر، خطيب ماهر، وهو خطيب الذاكرين لمصيبة الحسين× في عصره، ومقدّمهم لا يماثله أحد منهم، يكون القاؤه في مجالس ذكره أقلّ من ساعة، يصغي إليه فيها المستمعون بكلّهم وبغير ملل، ويستفيدون وتفيض منهم العيون... عالم بالعربية، يتكلَّم في القائه باللغة الفصحى فلا يلحن... وله ديوان شعر كبير في المراثي الإمامية رأيناه في النجف الأشرف بخطِّ بعض أولاده...).
[29] كامل الزيارات: ص201. ثواب الأعمال: ص83. تفسير القمّي: ج2، ص291، عنه بحار الأنوار: ج44، ص281، ح14.
[30] اُنظر: شرح نهج البلاغة: ج15، ص17.
[31] البداية والنهاية: ج4، ص55. السيرة النبوية (ابن كثير): ج3، ص95. واُنظر: أسد الغابة: ج2، ص48.
[32] تاريخ الإسلام: ج2، ص488.
[33] المصدر نفسه: ج2، ص496.
[34] صحيح البخاري: ج2، ص85. المغني: ج2، ص411. المُحلّى: ج5، ص146.
[35] اُنظر: الإمامة والتبصرة: ص52. كامل الزيارات: ص122 ـ 123، ح5.
[36] اُنظر: أمالي الشيخ الصدوق: ص198، ح6.
[37] اُنظر: شرح الأخبار: ج3، ص76 ـ 77، ح1002. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص226. مجمع الزوائد: ج9، ص201. المعجم الكبير: ج3، ص116، ح2847. تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص171. سير أعلام النُبلاء: ج3، ص284. بحار الأنوار: ج43، ص295 ـ 296، ح56.
[38] اُنظر: بحار الأنوار: ج44، ص292 ـ ص293، ح37. العوالم (الإمام الحسين): ص534، ح9. الأسرار الفاطمية: ص524.
[39] تفسير الإمام العسكري×: ص369، عنه بحار الأنوار: ج44، ص304، ح17. العوالم (الإمام الحسين): ص598.
[40] بحار الأنوار: ج44، ص293 ضمن ح37. العوالم (الإمام الحسين): ص534، ح9.
[41] اُنظر كامل الزيارات: ص207، ح9.
[42] الشزر: نظر فيه إعراض، كنظر المُعادي المبغض. العين: ج6، ص231.
[43] اُنظر: بحار الأنوار: ج44، ص293، ح38.
[44] أمالي الشيخ الصدوق: ص191، ح2. روضة الواعظين: ص169. إقبال الأعمال: ج3، ص28. بحار الأنوار: ج44، ص283، ح17، عن الأمالي. العوالم (الإمام الحسين×): ص538، ح1. وسائل الشيعة: ج14، ص505، ح8.
[45] اُنظر: بحار الأنوار: ج45، ص257، ح15.
[46] اُنظر: كامل الزيارات: ص207، الباب (33) وهو الباب الموسوم بـ (مَن قال في الحسين× شعراً فبكى وأبكى)، وذكر بهذا المضمون أحاديث سبعة.
[47] الحميري: «هو اسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة، ولد سنة 105 هـ بعُمان، ونشأ في البصرة في حضانة والديه الإباضيين إلى أن عقل وشعر، فهجرهما حتى مات والداه، ثمَّ غادر البصرة إلى الكوفة، وتوفي في الرميلة ببغداد في خلافة الرشيد سنة 173هـ، أغلب شعره في مدح الإمام أمير المؤمنين× وأهل بيته المعصومين^» اُنظر: هامش الدرّ النضيد: ص327.
[48] مجمع مصائب أهل البيت^: ج1، ص47 ـ 48.
[49] القصيدة للشيخ عبد الحسين الأعسم&. جاء في ترجمته: «هو الشيخ عبد الحسين بن الشيخ محمد علي بن الحسين بن محمد الأعسم الزبيدي النجفي، عالم فقيه، أصولي محقق، مؤلف أديب، شاعر مُفلّق مشهور، وقد ولد سنة (1177هـ) وتوفي سنة (1247هـ) بالطاعون العام في النجف الأشرف، له كتاب (ذرائع الإفهام إلى أحكام شرائع الإسلام)، وله مراثٍ في سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين× مشهورة ومتداولة» اُنظر: هامش الدرّ النضيد: ص17.
[50] التوبة: آية12.
[51] قال الحموي (في معجم البلدان: ج3، ص76): «ذكر ابن الكلبي، قال: لمّا رجع تبّع من قتال أهل المدينة يريد مكّة نـزل بالروحاء، فأقام بها وأراح فسمّاها الرّوحاء».
[52] التفسير الصافي: ج2، ص319 ـ 320. غاية المرام: ج5، ص48. بحار الأنوار: ج35، ص292.
[53] تفسير مجمع البيان: ج5، ص6 ـ 7. تفسير الميزان: ج9، ص162 ـ 166.
[54] اُنظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج15، ص218.
[55] حكاه في الميزان عن الدرّ المنثور للسّيوطي. اُنظر: الميزان: ج9، ص163.
[56] اُنظر: تفسير الأمثل: ج5، ص548.
[57] اُنظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج15، ص233.
[58] اُنظر: مجمع البحرين: ج6، ص277.
[59] اُنظر: تفسير الأمثل: ج5، ص548.
[60] اُنظر: المصدر السابق: ج5، ص546 ـ 547.
[61] قرب الإسناد: ص96 ـ ص97، ح327. تفسير البرهان: ج3، ص374 ـ 377. تفسير العيّاشي: ج2، ص77 ـ ص78، ح23، عنهما التفسير الصافي: ج2، ص324. تفسير نور الثقلين: ج2، ص188ـ 189، ح60. بحار الأنوار: ج32، ص185، ح133، عن تفسير العيّاشي.
[62] اُنظر: تفسير البرهان: ج3، ص374 ـ 377.
[63] اُنظر: تفسير الميزان: ج9، ص189.
[64] سيرة الأئمّة: ص152 ـ 153.
[65] اُنظر: الهداية الكبرى: ص203.
[66] ثمرات الأعواد: ص83 ـ 85.
[67] القصيدة لأستاذنا الخطيب البارع المرحوم الشيخ محمد سعيد المنصوري& وهو الخطيب الكبير وشيخنا وأستاذنا محمد سعيد بن الشيخ موسى المنصوري، ولد في النجف الأشرف عام 1350 هـ ق (في حدود 1931م)، درس المقدِّمات والسطوح في مسقط رأسه النجف الأشرف، ثمّ هاجر إلى إيران في حدود الستينيات، وسكن مدينة عبادان، وبقي ينتقل بينها وبين البصرة وبقية محافظات العراق إلى زمان مجيء زمرة البعثيين المجرمة، ثمّ انتقل إلى مدينة قم المقدّسة في سنة 1980 م. تتلمذ على يد مجموعة من فطاحل الخطابة، أمثال اُستاذه المرحوم السيد محمد سعيد العدناني الغريفي.
لأستاذنا المنصوري حسّ شعري رائع، وخطابة حسينيّة فريدة، ونغمة حنين نادرة وعبرات وآهات تُبكي صمَّ الصخور قبل رقائق القلوب.
انتقل إلى رحمة الله وإلى جوار مَن أحبّهم وندبهم ورثاهم وبكى عليهم ليلاً ونهاراً، إلى جوار رسول الله وآله الأطهار إن شاء الله تعالى، وذلك يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر جمادي الأول عام 1428 هـ ق، فشيّع تشييعاً مهيباً من قِبَل العلماء وطلاّب العلم وطلاّبه، ودُفن في مثواه الأخيرـ إلى جنب ولده الخطيب المرحوم الشيخ عبد الحسين المنصوري الّذي سبقه إلى القضاء وتركه بحسرةٍ شديدةٍ وألمٍ لطالما قرأتُه على صفحات محيّاه ـ وذلك في قم المقدّسة في مقبرة (باغ بهشت). ¬
للشيخ المنصوري& أسفار تبليغية في شتّى بقاع العالم الإسلامي، فقد سافر إلى الكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات وسوريا ولبنان فضلاً عن العراق وإيران، وغيرها من الدّول الأُخرى.
ترك آثاراً خالدة وصدقات جارية، منها؛ تدريسه ثلّة من الخطباء وخدمة المنبر الحسيني. وترك مؤلفات قيّمة في الشعر والأدب، منها: مفاتيح الدّموع، وميراث المنبر، ومصابيح المنبر، وديوان السعيد، وتحفة الفنّ، وخلاصة مقتل الحسين.
فسلامٌ عليه يوم ولد ويوم مات يلهج بذكر أبي عبد الله الحسين ×، ويوم يُبعث حيّاً.
[68] أمالي الشيخ الطوسي: ص478، ح11، عنه وسائل الشيعة: ج12، ص173 ـ 174. وبحار الأنوار: ج66، ص375، ح24.
[69] الكافي: ج3، ص513، ح2. الاستبصار: ج2، ص25 ـ 26، ح4. تهذيب الأحكام: ج4، ص38، ح8. وسائل الشيعة: ج9، ص182ـ 183، ح1. بحار الأنوار: ج19، ص180 ـ 181، ح29، عن الكافي.
[70] الفصول المهمّة: ج2، ص769. والآية 134 من سورة آل عمران.
[71] الحجر: آية85.
[72]اُنظر: عيون أخبار الرضا: ج2، ص264، ح50. أمالي الشيخ الصدوق: ص131، ح6. معاني الأخبار: ص374، ح1، عنه وسائل الشيعة: ج12، ص170، ح6، و ص171، ح7، عن الأمالي. وبحار الأنوار: ج68، ص421، ح56.
[73] نهج البلاغة: ج4، ص14، ح53، عنه وسائل الشيعة: ج9، ص457، ح4. بحار الأنوار: ج68، ص357، ح21.
[74] اُنظر: وسائل الشيعة: ج5، ص11، باب استحباب تزيّن المسلم للمسلم، وللغريب والأهل والأصحاب.
[75] اُنظر: الخصال: ص62ـ 63، ح90. علل الشرائع: ج2، ص557، ح1. الاختصاص: ص226. أمالي الشيخ الطوسي: ص537. مكارم الأخلاق: ص470. بحار الأنوار: ج72، ص222.
[76] اُنظر: وسائل الشيعة: ج20، ص79، ح8.
[77] وقعة صفين، ابن مزاحم: ص193.
[78] شرح نهج البلاغة: ج3، ص314.
[79] من أبـيات رائعة لابن الصيفي (الحيص بيص) المتوفى سنة (574هـ)، اُنظر: الوافي بالوفيات: ج15، ص104.
[80] روي عن أبي جعفر× أنّه قال: «كان فيما ناجى به موسى ربَّه أن قال يا ربِّ! ما بلغ من عيادة المريض من الأجر؟ فقال الله}: اُوكل بهِ مَلَكاً يعودُه في قبره إلى محشره». الكافي: ج3، ص121، ح9.
[81] مثير الأحزان: ص83، وعنه بحار الأنوار: ج45، ص141. العوالم (الإمام الحسين×): ص441.
[82] البيتان لمسعود بن عبد الله القايني، كما في مناقب آل أبي طالب: ج3، ص108.
[83] اُنظر: ثواب الأعمال: ص219، عنه بحار الأنوار: ج43، ص222 ـ 223، ح9.
[84] اُنظر: مجمع مصائب أهل البيت^: ج1، ص166ـ 167.
[85] القصيدة للسيد جعفر الحلي&، قال عنه السيد جواد شبّر& في أدب الطف: «السيّد جعفر كمال الدين الحلي النجفي، عُرفت هذه الأُسرة بالانتماء إلى الجدّ السّادس لصاحب هذه الترجمة، وهو السيد كمال الدّين بن منصور، فهو جدّ الأُسرة الكمالية المنتشرة في الحلّة وضواحيها والنجف والكوفة، وقد كتب عنها مفصّلاً الخطيب اليعقوبي في (البابليات)، كما أقام الشّواهد على شاعريته وسرعة البديهة عنده، وديوانه أصدق شاهد على سموّ شعوره، وكان من حقّه أن يطلق اسم (سحر بابل وسجع البلابل) على ديوانه قبل أن يجمع، والذي جمعه أخوه السيّد هاشم بعد وفاة الشاعر. توفي فجأة في شعبان لسبع بقين سنة (1315 هـ)، ودفن في وادي السّلام بالنجف الأشرف عند قبر والده على مقربة من مقام الإمام المهدي×، نشأ السيّد جعفر فاستطرف قدر حاجته من المبادئ، النحو والصّرف والمنطق والمعاني والبيان، وصار يختلف إلى مدارس العلماء وحوزاتها الحافلة بالفقه، وهو في كلّ ذلك حلو المحاضرة، سريع البداهة، حسن الجواب، نبيه الخاطر، متوقد القريحة، جريّ اللسان، برع في نظم الشّعر وهو دون الثّلاثين، وأصبح من الشّعراء المعدودين الّذين تلهج الألسن بذكرهم وتتغنّى بشعرهم... أشهر قصيدة له رائعته الّتي مطلعها:
وجه الصّباح عليّ ليلٌ مظلم وربيع أيـامـي عليّ مـحرّم
وهذه القصيدة التي تزيد على السّبعين بيتاً كلّها من الشّعر المنسجم... ». أدب الطف: ج8، ص99 ـ110.
[86] آل عمران: آية179.
[87] اُنظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج9، ص111.
[88] تفسير الكشّاف: ج1، ص179.
[89] الأحزاب: آية33.
[90] اقتباس من دعاء الافتتاح: «إنّك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إليَّ فاتبغّض إليك، وتتودّدُ إليَّ فلا أقبل منك، كأنَّ لي التطوّل عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إليّ، والتفضّل عليَّ بجودك وكرمك...». اُنظر: المصباح (الكفعمي): ص573. تهذيب الأحكام: ج3، ص109.
[91] حقيقة علم آل محمدٍ وجهاته: ص143، عن كتاب الإرشاد إلى ولاية الفقيه: ص254. لكن لم أعثر عليه.
[92] بصائر الدرجات: ص250، ح5. الكافي: ج1، ص257، ح3. ينابيع المعاجز: ص13. غاية المرام: ج4، ص57، ح2. تفسير نور الثقلين: ج2، ص522، ح208، عن الكافي. الفصول المهمة في أُصول الأئمّة: ج1، ص395. بحار الأنوار: ج25، ص323، رواه مختصراً عن الكافي، وفي ج26، ص197، ح8، رواه كاملاً عن البصائر.
[93] الأعراف: آية188
[94] الجن: آية26 ـ 27.
[95] دلائل الإمامة: ص183، ح6. نوادر المعجزات: ص109، ح5. فرج المهموم: ص237. مدينة المعاجز: ج3، ص453، ح25. الدُّرّ النظيم: ص532. بحار الأنوار: ج44، ص186، ح14، عن دلائل الإمامة.
[96] اُنظر: كتاب فقه الإمام الصادق×: ج2، ص262، وغيره.
[97] بصائر الدرجات: ص502. دلائل الإمامة: ص187 ـ 188، ح12. نوادر المعجزات: ص110. الخرائج والجرائح: ج2، ص771 ـ 772، ح93. ذوب النضّار: ص29، ح4، عن البصائر. مثير الأحزان: ص27. مدينة المعاجز: ج3، ص460 ـ 461، ح31. بحار الأنوار: ج42، ص81، ح12، عن البصائر وكذا: ج45: ص83 ـ 84، ح13.
[98] أمالي الشيخ الطوسي: ص677، ح11، عنه بحار الأنوار: ج45، ص177، ح27. العوالم (الإمام الحسين×): ص414، ح13.
[99] ذوب النضّار: ص30. مثير الأحزان: ص29. نـزهة الناظر: ص86. اللهوف: ص38. كشف الغُمة: ج2، ص239. معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول: ص94. بحار الأنوار: ج44، ص367. العوالم (الإمام الحسين×): ص217.
[100] اُنظر: أمالي الشيخ الصدوق: ص217. مدينة المعاجز: ج3، ص487. بحار الأنوار: ج44، ص313، وج58، ص182.
[101] المنتخب للطريحي: ج2، ص442 ـ 443، الباب الثاني (ولم ينسبها لأحدٍ، ولم أعثر على قائلها فللّهِ درّهُ وعلى الله أجره).
[102]كامل الزيارات: ص152، عنه بحار الأنوار: ج4، ص86، ح18. العوالم (الإمام الحسين×): ص155، ح2.
[103] تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص208. تهذيب الكمال: ج6، ص416. سير أعلام النبلاء: ج3، ص296، تاريخ الإسلام: ج5، ص8. البداية والنهاية: ج8، ص175. ترجمة الإمام الحسين (ابن عساكر): ص294، ترجمة الإمام الحسين (طبقات ابن سعد): ص57.
[104] من أخلاق الإمام الحسين×: ص55.
[105] نهج السعادة: ج2، ص361 ـ ص362. واُنظر: نهج البلاغة: ج1، ص231، ح118. تاريخ الطبري: ج4، ص58. الكامل في التاريخ: ج3، ص340. الإمامة والسياسة: ج1، ص124.
[106] الإرشاد: ج2، ص32، عنه بحار الأنوار: ج44، ص324. والعوالم (الإمام الحسين ×): ص173.
[107] موسوعة كلمات الإمام الحسين×: ص307.
[108] بحار الأنوار: ج44، ص331. العوالم (الإمام الحسين×): ص181. ينابيع المودّة: ج3، ص60.
[109] بحار الأنوار: ج44، ص332، و ج45، ص89، ح27. العوالم (الإمام الحسين ×): ص157، و ص181.
[110] بحار الأنوار: ج45، ص99. العوالم (الإمام الحسين ×): ص323.
[111] كامل الزيارات: ص151، ح7، عنه بحار الأنوار: ج45، ص85، ح16. العوالم (الإمام الحسين×): ص313.
[112] ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص64. البداية والنهاية: ج8، ص183.
[113] تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص208. تهذيب الكمال: ج6، ص416. سير أعلام النُّبلاء: ج3، ص296. تاريخ الإسلام: ج5، ص8. البداية والنهاية: ج8، ص175. ترجمة الإمام الحسين× (ابن عساكر): ص294، ترجمة الإمام الحسين × (طبقات ابن سعد): ص57.
[114] من أخلاق الإمام الحسين×: ص55.
[115] مثير الأحزان: ص16. بحار الأنوار: ج45، ص334. العوالم (الإمام الحسين×): ص183.
[116] مثير الأحزان: ص21. تاريخ الطبري: ج4، 281. مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص51.
[117] بحار الأنوار: ج44، ص334. العوالم (الإمام الحسين×): ص184.
[118] مناقب الإمام أمير المؤمنين×: ص261. تاريخ مدينة دمشق: ج14، 202. سير أعلام النبلاء: ج3، ص292. تهذيب التهذيب: ج2، ص307. الدر النظيم: ص546. النـزاع والتخاصم: ص96.
[119] الإرشاد: ج2، ص75. تاريخ الطبري: ج4، ص300. الكامل في التاريخ: ج4، ص42. مقتل الإمام الحسين (أبو مخنف): ص78. بحار الأنوار: ج44، ص373، عن الإرشاد. العوالم (الإمام الحسين×): ص224.
[120] اُنظر: الإرشاد: ص2، وص69. بحار الأنوار: ج44، ص366. العوالم (الإمام الحسين×): ص216.
[121] اُنظر: كتاب الركب الحسيني: ج3، ص13 ـ 22، مع تصرّف واختصار يسيرين.
[122] بحار الأنوار: ج44، ص379. العوالم (الإمام الحسين×): ص329.
[123] القصيدة لشاعر أهل البيت^ دعبل الخزاعي و«هو دعبل بن علي بن زرين بن سليمان الخزاعي، أبو علي الشاعر المشهور، يعود نسبه إلى خزاعة إحدى قبائل اليمن الشهيرة. ولد سنة 148هـ، أصله من الكوفة، ويقال إنّه من قرقيسا، وأقام ببغداد، له كتاب طبقات الشعراء وكتاب الواحد في مثالب العرب ومناقبها، وله من الشّعر الكثير حتى نقل عنه أنّه قال: مكثت نحو ستين سنةً ليس من يوم ذرَّ شارقه إلا وأنا أقول فيه شعراً... وقد نظم في جميع فنون الشّعر لكنّه ضاع منه الكثير، ومن الأسباب التي أدّت إلى إتلاف ديوانه أو فقده القهر والظّلم اللذين لاحقته السلطة بهما للقضاء عليه واضطهاده؛ لمهاجمته الخلفاء الحكام. من أشهر قصائده تلك التي مدح فيها أهل البيت^ هي الّتي تعرف بالتائية (مدارس آيات)، ولم يبقَ أديب أو مؤرّخ أو شاعر إلا وذكر بعضاً من أبياتها، قُتل مسموماً بأيدي الظالمين في الأهواز سنة (246)، وقد بلغ من العمر (98) سنة ودفن فيها».
نقلناه ملخّصاً من مقدّمة ديوانه بقلم ضياء حسين الأعلمي من (ص5 إلى30)، وهذه القصيدة من ديوانه (ص67 إلى ص68).
[124] موسوعة كلمات الإمام الحسين×: ص917، عن أسرار الحكماء: ص90. شرح إحقاق الحقّ: ج27، ص190 ـ 198.
[125] مسند الشهاب: ج2، ص32، الجامع الصغير: ج2، ص438، ح7488. جامع السعادات: ج1، ص284. التحفة السنيّة: ص56. شرح أصول الكافي: ج8، ص199.
[126] الكافي: ج2، ص313، ح5. كتاب الزهد: ص63، ح168. وسائل الشّيعة: ج1، ص101، ح9. بحار الأنوار: ج68، ص230، ح6، و ج69، ص307، ح2، عن الكافي.
[127] الكافي: ج2، ص306، ح3. قصص الأنبياء (الجزائري): ص463 ـ ص464. جامع السعادات: ج1، ص286. بحار الأنوار: ج14، ص254 ـ 255، ح49، عن الكافي، و ج70، ص244 ـ ص246، ح2، عن الكافي أيضاً.
[128] الصحيفة السجّادية: ص27.
[129] شرح نهج البلاغة: ج4، ص721.
[130] نهج السعادة: ج7، ص376. التحفة السنية: ص87. ونسبه إلى الإمام الصادق×، ومثله في الكافي: ج2، ص116، ح21، والاثنان بزيادة (لا يزال العبد) وفي كتاب الاعتقادات للشيخ الصدوق: ص69، رواه عن الإمام أمير المؤمنين×: بـ(لا يزال الرجل المسلم).
وفي الخصال: ص15، ضمن ح52 روى المقطع الأول منه، ح53 رواه كاملاً عن الإمام الصادق×، وكذا في ثواب الأعمال: ص164، ص178.
[131] ففي الكافي الشريف: ج2، ص232، ح6 عن الإمام الصادق× أنه قال: «مَن سرّته حسنتُه وساءته سيئته فهو مؤمن» ومثله في التوحيد: ص408، عن النبي’. بحار الأنوار: ج64، ص350، ح53، عن الكافي.
[132] عيون الحكم والمواعظ: ص261. شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين×: ص59. شرح نهج البلاغة: ج16، ص118، المناقب (الخوارزمي): ص375. جواهر المطالب: ص151، ح64. الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج1، ص541.
[133] مواقف الشيعة: ج3، ص260. واُنظر: شجرة طوبى: ج1، ص50.
[134] اُنظر: مثير الأحزان: ص13ـ 14. الإرشاد: ج2، ص32 ـ 33. اللهوف: ص16 ـ 17. بحار الأنوار: ج44، ص323 ـ 325. العوالم (الإمام الحسين×): ص173 ـ 174.
[135] اُنظر: اللهوف: ص78، بحار الأنوار: ج45، ص58. العوالم (الإمام الحسين×): ص303.
[136] القصيدة للسيد مهدي الأعرجي& باستثناء البيت الأخير، فإنّه لأستاذنا الخطيب الأديب الشيخ محسن الفاضلي (حفظه الله). قال السيد جواد شبّر& في أدب الطف: «السيد مهدي الأعرجي بن السيد راضي بن السيد حسين بن السيد علي الحسيني الأعرجي البغدادي، ولد السيد مهدي في النجف الأشرف سنة (1322 هـ)، درس فنّ الخطابة على يد خاله الخطيب الشهير الشيخ قاسم الحلّي، زاول نظم الشعر وعمره أربعة عشر سنة، وأوّل قصيدة نظمها هي قصيدة في رثاء الإمام الحسن السبط×:
قضى الـزّكي فنوّحوا يا محبـيه وابكوا عليه فذى الأملاك تبكيه
درس العربية والعروض على يد العلاّمة الكبير شيخ الأدب السيد رضا الهندي&، توفي السيد مهدي سنة (1359 هـ ق) غريقاً بشطّ الفرات في الحلّة يوم الخامس من شهر رجب، جمع ديوانه شقيقه الخطيب السيد حبيب. وللسيد الأعرجي ظرف وخفّة روح بالرّغم من الجهمة الّتي لا تفارق محيّاه، فلا تكاد تفوته النادرة والنكتة. وأمّا ولاؤه لأهل البيت وتفانيه في حبّهم فهو من ألمع ميزاته، ولا زلتُ أتمثّله في المآتم الحسينية يجهش بالبكاء وقد أفنى عمره في خدمة المنبر الحسيني». أدب الطف: ج9، ص193 ـ ص198.
[137] آل عمران: آية104.
[138] آل عمران: آية110.
[139] تهذيب الأحكام: ج6، ص181، ح22. مشكاة الأنوار: ص105. بحار الأنوار: ج97، ص94.
[140] المقنعة: ص808 ـ 809. تهذيب الأحكام: ج6، ص181، ح23. وسائل الشيعة: ج16، ص132، ح4. مشكاة الأنوار: ص105. بحار الأنوار: ج97، ص94.
[141] اُنظر: فقه الإمام جعفر الصادق×: ج2، ص283.
[142] اُنظر: التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج8، ص177 ـ 178.
[143] التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج8، ص178.
[144] تفسير العياشي: ج1، ص195، ح127. تفسير البرهان: ج2، ص89، ح3.
[145] اُنظر: منهاج الصّالحين للسيّد الخوئي+: ج1، ص351.
[146] منهاج الصّالحين للسيّد الخوئي+: ج1، ص352.
[147] بحار الأنوار: ج44، ص329. العوالم (الإمام الحسين×): ص179.
[148] اُنظر: الإرشاد: ج2، ص76 ـ 83. تاريخ الطبري: ج4، ص302 ـ 308. الكامل في التاريخ: ج4، ص46. مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص81 ـ ص93. بحار الأنوار: ج44، ص375 ـ 380. العوالم (الإمام الحسين×): ص225 ـ ص230.
[149] قال عنه السيد الخوئي &في كتابه القيّم معجم رجال الحديث: ج10، ص175، رقم (6013): «الطرماح بن عدّي: عدّه الشيخ تارةً من أصحاب أمير المؤمنين× قائلاً: رسوله إلى معاوية، وأُخرى من أصحاب الحسين×».
[150] اُنظر: بحار الأنوار: ج44، ص378.
[151] الأبيات للسيد رضا الهندي&. قال عنه السيد جواد شبّر& في أدب الطف: ج9، ص242 ـ 255: «السيد رضا الهندي شيخ الأدب في العراق، والعالم الجليل المؤرّخ، والبحّاثة الشهير، وهو ابن السيّد محمّد ابن السيّد هاشم الموسوي الهندي.
وُلد+ في الثامن من شهر ذي القعدة سنة (1290 هـ)، وهاجر إلى سامراء بهجرة أبيه سنة (1298 هـ) حين اجتاح النجف وباء الطاعون، وكان خامسَ إخوته الستّة، ومكث يواصل دروسه في سامراء، وكان موضع عناية من آية الله المجدِّد الشيرازي؛ لذكائه وسرعة البديهة وسعة الاطّلاع، وفي النجف واصل جهودَه العلمية على أساطين العلم حتّى نال درجة الاجتهاد...
مؤلفاته: الميزان العادل بين الحقّ والباطل في الردّ على الكتابيين (مطبوع)، وبلغة الراحل في الأخلاق والمعتقدات، والواقي في شرح الكافي في العروض والقوافي، سبيكة المسجد في التأريخ بأبجد (وقد فُقِد)، وشرح غاية الإيجاز في الفقه.
أمّا الرائعة التي ختم بها حياته وطلب أن تكون معه في قبره فهي هذه القطعة الوعظية:
أرى عُمـري مـؤذنا بالـذهاب تـمـرُّ لـيـالـيـه مـرَّ السّـحــــاب
وتــــفــجـأنـي بــيـــض أيــامـــه فـتسـلـخُ مـنّـي سـواد الشّباب
کانت وفاتُه بالمشخاب فجأة بالسكتة القلبية، وذلك بعد ظهر يوم الأربعاء 22 جمادى الأُولى سنة (1362هـ) المصادف (26 مارس سنة 1943 م)، وحُمل جثمانه على الأعناق إلى قضاء أبي صخير في النجف في صبيحة اليوم الثاني، وكان يوماً مشهوداً حتى دفن بمقبرة الأسرة الخاصّة، وأقام زعيم الحوزة الدينية السيد أبو الحسن [الأصفهاني] الفاتحة على روحه في مسجد الشيخ الأنصاري بالقرب من دار الفقيد... ».
[152] المقصود هنا (الجان).
[153] تحف العقول: ص246، عنه بحار الأنوار: ج75، ص117، ح5.
[154] نهج البلاغة: ج4، ص53، رقم: 237.
[155] الكافي: ج2، ص84، ح5، عنه وسائل الشيعة: ج1، ص62. بحار الأنوار: ج67، ص236.
[156] مستند الشيعة: ج2، ص50.
[157] اُنظر: شرح أصول الكافي: ج8، ص263. بحار الأنوار: ج70، ص255.
[158] تفسير الميزان: ج1، ص28.
[159] اُنظر: بحار الأنوار: ج70، ص234.
[160] الأنبياء: آية90.
[161] الأعراف: آية56.
[162] اُنظر: بحار الأنوار: ج70، ص235 ـ 236.
[163] شرح أصول الكافي: ج1، ص254.
[164] مرآة العقول: ج10، ص101.
[165] المرجل: هو قدر من نحاس. اُنظر: كتاب العين: ج6، ص208. والأثافي هي الحجارة التي تُنصب وتُجعل القدر عليها. اُنظر: لسان العرب: ج9، ص3.
[166] طه: آية1.
[167] تفسير البرهان: ج5، ص155 ـ 156، عن الاحتجاج: ص219.
[168] عيون أخبار الرضا: ج1، ص193، ضمن حديث: 4، عنه بحار الأنوار: ج68، ص174، ح10، و ج70، ص353، ح55.
[169] مُسكّن الفؤاد: ص87. بحار الأنوار: ج79، ص153.
[170] بحار الأنوار: ج45، ص46.
[171] اللهوف في قتلى الطفوف: ص40. المُحتضر: ص82. بحار الأنوار: ج44، ص364. العوالم (الإمام الحسين×): ص214.
[172] اُنظر: المحتضر: ص41.
[173] الأبيات من قصيدةٍ رائعة للسيّد صالح الحلي&. قال عنه في أدب الطف (ج9، ص204 ـ 206): «أبو المهدي السيّد صالح ابن السيّد حسين ابن السيّد محمّد، حسيني النسب، حلّي المحتد والمولد، وتناديه عامة الناس (أبو مهدي).
خطيبٌ شهير، أو أشهر خطباء المنبر الحسيني؛ إذ إنّ شهرته الخطابية لم يحصل عل مثلها خطيب حتّى اليوم، يتحلّى بجرأةٍ قوية، وبسطة في العلم والجسم، ولد سنة (1289 هـ) في الحلة، وهاجر منها إلى النجف (1308 هـ) وهو في التاسعة عشرة من عُمره، وأكمل دروسه في العربية والمعاني والبيان عِندَ الشيخ سعيد الحلّي، والشيخ عبد الحسين الجواهري، ودرس كتابي المعالم والقوانين في الأصول على يد العلاّمة الشهير السيّد عدنان ابن السيّد شبّر الغريفي الموسوي، وكتابي الرسائل والمكاسب عند الشيخ علي ابن الشيخ باقر الجواهري، وعلى الشيخ ملا كاظم الخراساني ¬
صاحب الكفاية، وهو في كل ذلك يتعاهد ملكته الأدبية، ولم تكن له يومئذٍ صلة بالخطابة، وفي سنة (1318هـ) أحسَّ من نفسه القدرة على الخطابة وقوّة البيان وطلاقة اللسان، فتوجّه أوّل ما توجّه إلى حفظ الكثير من (نهج البلاغة) من خطب الإمام أمير المؤمنين×، ولم يكُ في عصره من الخطباء المجدّدين في الفنّ إلا المرحوم الشيخ كاظم سبتي... [وبعدما كبر] ضعفت قوته وضعف عزمُه ولبث ملازماً بيته إلى أن توفاه الله ليلة السبت (29 شوال 1359 هـ) في الكوفة مُحمل على الرؤوس تعظيماً له، حتى دُفن بوادي السلام في مقام المهدي، ونعاه المنبر، وبكته الخطابة، ورثاه العلامة الجليل الشيخ عبد المهدي مطر بقصيدة فاخرة منها:
نـعـــتــك الـخـطابـــة والـمـنبـرُ ونـاح لــك الـطرس والـمزيرُ
وفيك انطـوت صفـحةٌ للبـيان بغــيــر لــسـانـِك لا تُـنــــشــرُ»
[174] تاريخ الطبري: ج4، ص262. روضة الواعظين: ص173 مناقب آل أبي طالب: ج3، ص241 ـ 242. كتاب الفتوح: ج5، ص30. بحار الأنوار: ج44، ص334. العوالم (الإمام الحسين×): ص183 ـ 184.
[175] اُنظر: مُسند ابن راهويه: ج3، ص282، ح1477. المحجّة البيضاء: ج4، ص120، عنه سنن النبيّ: ص126، ح4. مجموعة ورّام: ج1، ص89.
[176] الشهيد الخالد مسلم بن عقيل: ص113 ـ 114.
[177] سفير الحسين مسلم بن عقيل: واجهة الكتاب المذكور.
[178] هانيء بن هانيء السُبيعي: هو آخر رسول أرسله أهلُ الكوفة إلى الإمام الحسين× مع سعيد بن عبد الله الحنفي يستدعونه إلى الكوفة، ولم يُعلم حاله إلى أين انتهى، ولم يُذكر في عداد أصحاب الحسين× الّذين قُتلوا معه في المعركة. اُنظر: الفوائد الرّجالية: ج4، ص50. (المتن والهامش).
[179] إبصار العين في أنصار الحسين: ص126.
[180] اُنظر: كتاب الشهيد الخالد مسلم بن عقيل: ص114 ـ 115.
[181] والمقصود به «الطِّيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيء... وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشّارع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنّه ليس له تأثير في جلب نفعٍ أو دفعٍ». النهاية في غريب الحديث: ج3، ص152.
[182] مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص51 ـ 72. مثير الأحزان: ص21. الأخبار الطوال: ص243. تاريخ الطبري: ج4، ص281. البداية والنهاية: ج8، ص181. والمقصود من كلمة (أنَّ الرائد الذي يقدم القوم يطلب لهم الماء والكلاء والطّالب صلاحهم لا يكذّبهم؛ لأنّه لو كذّبهم غشّهم وهلك معهم) اُنظر: بحار الأنوار: ج59، ص104. تفسير التبيان: ج2، ص124. تنـزيل الآيات على الشّواهد من الأبيات: ص414.
[183] الشّهيد مسلم بن عقيل: ص111 ـ 157. بتصرّف واختصار.
[184] مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص45. الإرشاد: ج2، ص54. مقاتل الطالبيين: ص71. تاريخ الطّبري: ج4، ص277. إعلام الورى: ج1، ص442. روضة الواعظين: ص174. العوالم (الإمام الحسين×): ص199.
[185] قال عنها الطّبري (في تأريخه: ج4، ص277): «أُمَّ ولد كانت للأشعث بن قيس فأعتقها، فتزوّجها أسيد الحضرمي، فولدت له بلالاً».
[186] مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص45. كتاب الفتوح: ج5، ص50. الإرشاد: ج2، ص54. الدرّ النظيم: ص543 ـ 544. روضة الواعظين: ص175. بحار الأنوار: ج44، ص350.
[187] سمعت هذا الکَوريز من سماحة أُستاذي الشّيخ المنصوري& في داره المحروسة بقم المقدّسة، سنة (1427 هـ ق).
[188] اُنظر: الإرشاد: ج2، ص54 ـ ص65. مثير الأحزان: ص23 ـ 26. بحار الأنوار: ج44، ص350 ـ 357. مجمع مصائب أهل البيت^: ج1، ص246 ـ 258. بتصرّف واختصار.
[189] الأبيات مشهورة وهي ـ على ما في مثير الأحزان صفحة: 26 ـ لعبد الله بن الزبير الأسدي.
[190] القصيدة للسّيد مهدي بحر العلوم جاء في ترجمته في هامش الدرّ النضيد: ص264. «ولد في كربلاء سنة (1155هـ)، وتوفي في النجف سنة (1212هـ)، ودُفن قريباً من قبر الشّيخ الطّوسي وقبره مشهور، ومن أقوال العلماء فيه، هو الإمام العلاّمة رئيس الإمامية وشيخ مشايخهم في عصره. الفقيه الأصولي الكلامي المفسّر المحدّث الرجالي، الماهر في المعقول والمنقول، المتضلّع بالأخبار والحديث والرّجال، وهو نفسه شاعر مطبوع ينظم الشّعر كثيراً... قال في رثاء مسلم بن عقيل:
عين جودي لمسلم بن عقيل لرسول الحسين سبط الرسول».
[191] الشورى: آية23.
[192] تفسير فرات الكوفي: ص391، ح15. أسباب النـزول (الواحدي): ص251. تفسير الثعلبي: ج8، ص310. التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج27، ص164.
[193] اُنظر: تفسير البرهان: ج7، ص83.
[194] المحاسن: ج1، ص145، ح28، عنه بحار الأنوار: ج23، ص240، ح9.
[195] تفسير الكشّاف: ج4، ص220.
[196] التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج27، ص166.
[197] صحيح البخاري: ج6، ص37، ومثله في مسند أحمد: ج1، ص286. سُنن التّرمذي: ج5، ص54. المستدرك على الصحيحين: ج2، ص444. السنن الكبرى (النسائي): ج6، ص453.
[198] ص: آية86.
[199] اُنظر: تفسير الميزان: ج18، ص48.
[200] المصدر السابق.
[201] قال ابن السكيت ـ في ترتيب إصلاح المنطق: ص149 ـ: « وسميت الخلاة مخلاة؛ لأنّه يجعل فيها الخلي»، وفي لسان العرب: ج14، ص243 «قال الأصمعي: (الخلي) الرطب من الحشيش، وبه سُميت الخلاة، فإذا يبس فهو حشيش».
[202] اُنظر: أمالي الشّيخ الصّدوق، المجلس العشرون: ص143 ـ 148، ح2، عنه بحار الأنوار: ج45، ص100 ـ 105، ح1. العوالم (الإمام الحسين×): ص351 ـ 358، ح1.
[203] ثمرات الأعواد: ج1، ص150.
[204] إبصار العين في أنصار الحسين: ص87 ـ 88.
[205] القصيدة للسيد رضا الموسوي الهندي، كما وجدتُها في ديوانه: ص53. وقد تقدّمت ترجمتُه في المحاضرة التاسعة من هذا الكتاب، فراجع.
[206] كفاية الأثر: ص228، عنه بحار الأنوار: ج44، ص139، ح6. ومستدرك الوسائل: ج8، ص211، ح1.
[207] الإخوان (ابن أبي الدنيا): ص147، الطبقات الكبرى: ج6، ص335، و ج7، ص177. والكلّ نسبوه للحسن البصري.
[208] ذكره العيني في عُمدة القاري: ج15، ص216، ولم ينسبه لأحد، ومثله أبن أبي شيبة الكوفي في المُصنّف: ج6، ص121، وابن أبي الحديد في شرح النهج: ج16، ص99، لكنه قال ـ في ج18، ص48: قالطُرفة:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فإنَّ القرين بالمقارن يقتدي
وفي جامع البيان: ج5، ص123 نسبه إلى عدي بن زيد.
[209] الخصائص الفاطمية: ج1، ص100، وفيه (عاشر) بدل (صاحب)، ولم يُعرف قائله.
[210] الحجرات: آية10.
[211] آل عمران: آية103.
[212] نهج البلاغة: ج1، ص222، خطبة113.
[213] المصدر نفسه: ج4، ص72، حكمة رقم295، عنه بحار الأنوار: ج64، ص195، و ج71، ص164. شرح أُصول الكافي: ج9، ص200.
[214] خزانة الأدب: ج7، ص460. فتح الباري: ج8، ص237. عُمدة القارئ: ج18، ص257. مغني اللبيب: ج1، ص61، شاهد رقم(85)، شرح الرضي على الكافية: ج4، ص402، شاهد رقم(885). والبيتان هما من قصيدة لـ (المثقب العبدي) على ما وجدته في أكثر المصادر.
[215] شرح نهج البلاغة: ج18، ص179. ونسبه لأبي الطيّب المتنبّي، وهو المعروف المشهور، واُنظر: يتيمة الدهر: ج1، ص251. تفسير أبي السعود: ج8، ص34.
[216] ثمرات الأعواد: ج1، ص206 ـ 207.
[217] من دروس أُستاذنا المرحوم الشيخ محمد سعيد المنصوري&.
[218] القصيدة للسيد صالح القزويني النجفي& في رياض المدح والرثاء: ص35 ـ 36، وجاء في هامش المصدر المذكور «السيّد صالح ابن السيّد مهدي ابن السيّد رضا الحُسيني القزويني الأصل البغدادي المسكن، فقيهٌ وأديبٌ جهبذ كثير الشعر، حسن الكلام، مُجيد الوصف، وله قصائد في مدح أئمّة أهل البيت الطاهر^ ومراثيهم استوفى بها كثيراً من فضائلهم ومعجزاتهم. له الدرر الغرويّة في أئمة البريّة، وهو ديوان شعر يشتمل على أربع عشرة قصيدة كلّ قصيدة في إمام، يذكر فيها مناقبه ووفاته، وهي قصائد طويلة جدّاً. توفّي في بغداد سنة (1306 هـ) ونقل إلى النجف».
[219] الكافي: ج2، ص639، ح6. واُنظر: أمالي الشيخ الصّدوق: ص767، ح7. تحف العقول: ص366. روضة الواعظين: ص387. وسائل الشيعة: ج12، ص25 ـ 26، ح1، عن الكافي. بحار الأنوار: ج71، ص173، ح1، عن الأمالي: ج75، ص249 ـ 250.
[220] الأعراف: آية156.
[221] إكسير المحبّة: ص3 ـ 4. غرر الحكم: حكمة3353.
[222] شرح أصول الكافي: ج11، ص97 ـ 98.
[223] بحار الأنوار: ج71، ص236.
[224] شرح أصول الكافي: ج11، ص97 ـ 98.
[225] النجيب: الفاضل من كُلِّ حيوان (النهاية في غريب الحديث: ج5، ص17 مادة نجب)، وفي (ج1، ص16) قال: النجيب: التام الخلق الحسن المنظر. وفي القاموس المحيط: ج1، ص130 (النجيب: الكريم الحسب).
[226] عيون المعجزات: ص91. مدينة المعاجز: ج6، ص343 ـ 344، ح110. بحار الأنوار: ج48، ص85، ح105، عن عيون المعجزات.
[227] شرح أصول الكافي: ج11، ص97 ـ 98.
[228] غرر الحكم: حكمة1555.
[229] مناقب آل أبي طالب: ج3، ص216، عنه مدينة المعاجز: ج4، ص84، ح155. بحار الأنوار: ج45، ص303. العوالم (الإمام الحسين×): ص624.
[230] في بعض المصادر (وأبناء).
[231] الإرشاد: ج2، ص91. روضة الواعظين: ص183. إعلام الورى: ج1، ص455. بحار الأنوار: ج44، ص392. العوالم (الإمام الحسين×): ص243 ـ 244.
[232] ثمرات الأعواد: ج1، ص210.
[233] ثمرات الأعواد: ج1، ص210 ـ 211.
[234] مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص145 ـ 147.
[235] ثمرات الأعواد: ج1، ص210 ـ 213.
[236] إبصار العين: ص106.
[237] لم أعثر على ناظمها (فلِلِّهِ درّهُ وعلى الله أجرُه).
[238] الحديد: آية19.
[239] الحديد: آية18.
[240] العصر: آية3.
[241] الكافي: ج2، ص25، ح1. الفصول المهمّة في أُصول الأئمّة: ج1، ص430، ح3. بحار الأنوار: ج65، ص248، ح8، عن الكافي.
[242] الكافي: ج2، ص26، ح5.
[243] البقرة: آية82.
[244] النور: آية62.
[245] مريم: آية41.
[246] مريم: آية56.
[247] المائدة: آية75.
[248] النساء: آية69.
[249] تفسير الميزان: ج19، ص162.
[250]اُنظر: تفسير الأمثل: ج18، ص53.
[251] بحار الأنوار: ج43، ص10.
[252] البقرة: آية143.
[253] اُنظر: تفسير الأمثل: ج18، ص53.
[254] الخصال: ص636.
[255] الخصال: ص184، ح254.
[256] عيون أخبار الرضا: ج1، ص16، ح30.
[257] كامل الزّيارات: ص440، باب85، ح1.
[258] اُنظر: الخصائص العباسية: ص197 ـ 200.
[259] اُنظر: كتاب الخصائص العبّاسية: ص193 ـ 194.
[260] اُنظر: تفسير الميزان: ج19، ص162.
[261]مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص176، عنه بحار الأنوار: ج22، ص274.
[262] هذه الأبيات من قصيدة عصماء للمرحوم السيد جعفر الحلّي.
[263] هذه الأبيات من قصيدة رائعة للمرحوم الشيخ حسن قفطان.
[264] القصيدة للسيد جعفر الحلي&، تقدّمت ترجمته في المحاضرة الخامسة من هذا الكتاب، فراجع.
[265] الخصال: ص156، ح197، وقريب منه قرب الإسناد: ص64، ح203. الفصول المهمّة في أُصول الأئمّة: ج1، ص358، ح1. بحار الأنوار: ج2، ص15، ح29، عن قرب الإسناد، و ج8، ص34، ح2، عن الخصال، و ج97، ص12، ح24، عن قرب الإسناد أيضاً.
[266] معجم مقاييس اللغة: ج3، ص201.
[267] النساء: آية64.
[268] البقرة: آية254.
[269] المُدّثر: آية46 ـ 48.
[270] الأنعام: آية94.
[271] الأنعام: آية51.
[272] طه: آية109.
[273] الأنبياء: آية28.
[274] صحيح مُسلم: ج1، ص131. مسند أحمد: ج2، ص426. الشرح الكبير: ج1، ص384 ـ 385. سنن ابن ماجة: ج2، ص144، ح4307. سنن الترمذي: ج5، ص238. والحديث مستفيض في كتب الجمهور.
[275] الكامل: ج4، ص101. التوحيد: ص407. أمالي الشيخ الصدوق: ص56. عيون أخبار الرضا: ج2، ص124 ـ ص125، ح35. مَن لا يحضره الفقيه: ج3، ص574، ح4963. روضة الواعظين: ص500. مشكاة الأنوار: ص565. وسائل الشيعة: ج15، ص334، ح4. بحار الأنوار: ج8، ص34، ح4، عن عيون الأخبار.
[276] الصحيفة السجادية: ص198 (دعاؤه عند ختم القرآن). إقبال الأعمال: ج1، ص453.
[277] مسند أحمد: ج2، ص307 وص518. المستدرك على الصحيحين: ج1، ص70. مجمع الزوائد: ج10، ص404. عمدة القارئ: ج23، ص129. بغية الباحث: ص340. فتح الباري: ج11، ص385.
[278] المحاسن: ج1، ص186، ح198. بحار الأنوار: ج8، ص41، ح27.
[279] الكافي: ج3، ص270، ح15، تهذيب الأحكام: ج9، ص107، ح199. وسائل الشيعة: ج4، ص24، ح3. بحار الأنوار: ج47، ص7 ـ 8، ح23، عن الكافي.
[280] عيون أخبار الرضا: ج2: ص71، ح292، عنه بحار الأنوار: ج8، ص40 ـ 41، ح25.
[281] اُنظر: محاضرات في الإلهيات: ص459.
[282] الجنّ: آية 18.
[283] اُنظر: محاضرات في الإلهيات: ص459 ـ 462.
[284] عمدة الطالب: ص356. سرُّ السلسلة العلوية: ص89. مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص176.
[285] مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص179.
[286] مجمع مصائب أهل البيت^: ج1، ص320 ـ 321.
[287] القصيدة للسّيد صالح الحلي&. تقدمت ترجمته في المحاضرة العاشرة من هذا الكتاب فراجع.
[288] ديوان مفاتيح الدموع: ص145.
[289] كنـز العُمّال: ج16، ص456، ح45409. الجامع الصغير: ج1، ص51، ح311. كشف الخفاء: ج1، ص74، ح174. ينابيع المودّة: ج2، ص361، ح32.
[290] الاختصاص: ص193. الفصول المختارة: ص39. عيون المعجزات: ص63. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص307. تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص402. تهذيب الكمال: ج20، ص401 ـ 402. بحار الأنوار: ج46، ص126.
[291] الدرّ المنثور: ج6، ص7. نظم درر السُمطين: ص86. تفسير الثعلبي: ج8، ص314. شواهد التنـزيل: ج2، ص212. تفسير القُرطبي: ج16، ص24. الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج1، ص159. ينابيع المودّة: ج2، ص455.
[292] نقلنا ذلك من مجموعة رسائل لسماحة الشيخ لطف الله الصافي: ج2، ص77 ـ 78.
[293] الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ج2، ص25.
[294] الكافي: ج6، ص39، ح2، عنه وسائل الشيعة: ج21، ص393، ح4. بحار الأنوار: ج17، ص30، ح9.
[295] اُنظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ج2، ص25 ـ 26.
[296] المستدرك على الصّحيحين: ج3، ص130. مجمع الزوائد: ج9، ص132. المعجم الكبير: ج23، ص380. الاستيعاب: ج3، ص1101. الجامع الصغير: ج2، ص554، ح8319. كنـز العُمّال: ج11، ص601، ح32902.
[297] مناقب أمير المؤمنين (محمد بن سليمان الكوفي): ج2، ص476.
[298] الشورى: آية23.
[299] صحيح البخاري: ج4، ص210 و ص219. فضائل الصحابة: ص78. عُمدة القاريء: ج16، ص223، ح4173. المُصنّف: ج7، ص526، ح1، الآحاد والمثاني: ج5، ص361، ح2954. السُّنن الكُبرى: ج5، ص97، ح8371. المعجم الكبير: ج22، ص404. الجامع الصغير: ج2، ص208، ح5833. كنـز العُمّال: ج12، ص108، ح34222.
[300] الخصال: ص360، ح49. أمالي الشّيخ الصّدوق: ص60، ح3. فضائل الشيعة: ص5، الحديث الثاني. روضة الواعظين: ص271. غاية المرام: ج6، ص87، الحديث الثالث والأربعون. بحار الأنوار: ج7، ص248، ح2. عن فضائل الشّيعة، وج27، ص158، ح3، عن الخصال.
[301] إشارة إلى قوله’: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له». اُنظر: الحديث في المصادر التالية: المجموع: ج1، ص19 و ج15، ص520. صحيح ابن خزيمة: ج4، ص122. صحيح ابن حبّان: ج7، ص286. كنـز العُمّال: ج15، ص952، ح43655. بحار الأنوار: ج2، ص22 ـ 23، ح65 وح70.
[302] اُنظر: مقاتل الطالبيين: ص58. إبصار العين: ص72.
[303] النصّاريات الكبرى: ص16 ـ 17.
[304] المناسم جمع منسم، وهو خُفُّ البعير. مجمع البحرين: ج6، ص175.
[305] لم أعثر على ناظِمها (فلله درّه وعلى الله أجرُه).
[306] المحاسن: ج1، ص228. مشكاة الأنوار: ص236. بحار الأنوار: ج1، ص214، ح17، عن المحاسن.
[307] الزُّمر: آية9.
[308] الكافي: ج1، ص33، ح7. الخصال: ص40 ـ 41، ح28. روضة الواعظين: ص6. كنـز الفوائد: ص13. معدن الجواهر: ص25. أعلام الدين: ص169. بحار الأنوار: ج1، ص167 ـ 168، ح12، عن الخصال، وص195، ح12 عن الروضة، وج74، ص168، ح6، عن الكنـز.
[309] الكافي: ج1، ص32، ح1. أمالي الشيخ الصدوق: ص340، ح13. معاني الأخبار: ص141، ح1. مشكاة الأنوار: ص241. مستطرفات السرائر: ص626. وسائل الشيعة: ج17، ص327، ح6، عن الكافي. بحار الأنوار: ج1، ص211، ح5، عن الأمالي.
[310] ففي نهج البلاغة: ج2، ص44 «العامل بغير علمٍ كالسائر على غير طريق، فلا يزيده بُعده عن الطريق إلا بُعداً من حاجته». وفي المحاسن: ج1، ص198، ح24، عن الإمام الصادق×: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، لا يزيده سرعة السير إلا بُعداً». ومثله في الكافي: ج1، ص43، ح1.
[311] فعن النبي الأكرم’ أنّه قال: «ركعتان من عالمٍ أفضل من سبعين ركعة من غير عالمٍ» كنـز العُمال: ج1، ص154، ح28786. وفي رسائل الشهيد الثاني: ص147، قال:«ولهذا قيل: ركعتان من عالمٍ أفضل من عِبادة سنةٍ من جاهل». والأحاديث في هذا المجال كثيرة.
[312] الإسراء: آية23.
[313] الكافي: ج2، ص161، ح12. وسائل الشيعة: ج21، ص488 ـ 489، ح3، بحار الأنوار: ج22، ص267، ح11 عن الكافي.
[314] مكارم الأخلاق: ص334. بحار الأنوار: ج88، ص220 ـ ص221. مستدرك الوسائل: ج6، ص348، ح6، عن مكارم الأخلاق، وفيه بدل (ربِّ) في الركعة الأولى (ربّنا)، لكن جاء في المصدر كما أثبتناه. مفاتيح الجنان (الباقيات الصالحات): ص718.
[315] الكافي: ج2، ص159 ـ 160، ح9، عنه وسائل الشيعة: ج21، ص491، ح1. كتاب الزهد: ص40، ح107. بحار الأنوار: ج71، ص49، ح9، عن الكافي.
[316] لقمان: آية14.
[317] الأحقاف: آية15.
[318] اُنظر: مقتل الإمام الحسين× (أبو مخنف): ص170، عنه مقاتل الطالبين: ص58. شرح الأخبار: ج3، ص179 ـ 180. الإرشاد: ج2، ص107 ـ 108. مثير الأحزان: ص52. بحار الأنوار: ج45، ص34 ـ 35.
[319] مجمع مصائب أهل البيت^: ج1، ص375 ـ 376.
[320] القصيدة للسيّد صالح الحلّي&، تقدَّمت ترجمته في المحاضرة العاشرة من هذا الكتاب، فراجع.
[321] الخصال: ص568. تحف العقول: ص263. أمالي الشيخ الصدوق: ص453. مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص622، ح3214. روضة الواعظين: ص367. وسائل الشيعة: ج15، ص 175. بحار الأنوار: ج71، ص6، ح1، عن الخصال.
[322] اللهوف في قتلى الطفوف: ص48. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص224. مثير الأحزان: ص32. مجمع الزوائد: ج9، ص192. المعجم الكبير: ج3، ص115. نـزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص88. تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص218. تاريخ الإسلام: ج5، ص12. كشف الغُمّة: ج2، ص242. بحار الأنوار: ج44، ص192.
[323] البقرة: آية200.
[324] الصحيفة السجادية: ص129. دعائه× لأبويه دعاء رقم 24. المصباح (الكفعمي): ص162.
[325] الكافي: ج5، ص135. علل الشرائع: ج2، ص524. عيون أخبار الرضا: ج1، ص103. معاني الأخبار: ص155. مَن لا يحضره الفقيه: ج3، ص177، ح3669. الاستبصار: ج3، ص48، ح1، و ح2. تهذيب الأحكام: ج6، ص343، ح82، و ح83. وسائل الشيعة: ج7، ص263، ح1، و ح2، و ج20، ص291، ح5. بحار الأنوار: ج47، ص226، ح14، عن الكافي. والحديث مستفيض في كتب الخاصّة والعامّة.
[326] الأنابير: جمع (الأنبار) بيت التّاجر الّذي ينضد فيه الغلال والمتاع. (حاشية المصدر)
[327] البدر: جمع البدرة الكيس الموضوعة فيه الدراهم والدنانير، كمية عظيمة من المال. (حاشية المصدر)
[328] الوقير: الذليل المُهان، اُنظر: تاج العروس: ج7، ص60.
[329] تفسير الإمام العسكري×: ص421، ح288. بحار الأنوار: ج17، ص272.
[330] شرح رسالة الحقوق للسيّد حسن القبانچي&: ج1، ص561 ـ 578.
[331] اُنظر: تفسير الثعلبي: ج6، ص93. تفسير البيضاوي: ج3، ص441.
[332] شرح رسالة الحقوق للسيّد حسن القبانچي&: ج1، ص575 ـ 577.
[333] أمالي الشيخ الطوسي: ص280، ح79. عُدّة الداعي: ص121. وسائل الشيعة: ج7، ص130، ح6، عن الأمالي. بحار الأنوار: ج71، ص72، ح57، وص396، ح23، وج72، ص31، ح10، وج90، ص356، ح6، والجميع عن الأمالي.
[334] الشعر النصّاري كلّه من الملحمة الخالدة النصاريات الكُبرى: ص11 ـ 15.
[335] اُنظر: مقاطع مقتل عليّ الأكبر× في ثمرات الأعواد: ج1، ص229 ـ 235. مجمع مصائب أهل البيت^: ج1، ص329 ـ ص428. إبصار العين: ص21 ـ 23.
[336] هذه القصيدة لأستاذنا الخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري& ذكرها في كتابه ميراث المنبر: ص211، وقد تقدّمت ترجمته في المحاضرة الرابعة من هذا الكتاب، فراجع.
[337] مكارم الأخلاق: ص220. الجامع الصغير: ج1، ص381، ح2489 (مع تقديم وتأخير)، ومثله في كنـز العُمال: ج16، ص457، ح45416. روضة الواعظين: ص369، عنه وسائل الشيعة: ج21، ص482، ح9. بحار الأنوار: ج71، ص80، و ج101، ص92، ح19.
[338] اُنظر: الكافي: ج2، ص160، ح11، رواية زكريا بن إبراهيم حيث أمره الإمام الصادق× ببرّ أُمّه وأبيه وهما على دين النصرانية وهو قد أسلم. فقال له الإمام×: «فاُنظر أُمّك فبرّها...».
[339] النساء: آية11.
[340] روضة الواعظين: ص369. مجمع الزوائد: ج8، ص156. المعجم الأوسط: ج6، ص82. المعجم الصغير: ج2، ص21. نظم درر السُمطين: ص177. تذكرة الموضوعات: ص131. الكامل: ج6، ص160.
[341] روضة الواعظين: ص369. مكارم الأخلاق (ابن أبي الدُنيا): ص74، وفيه (للولد عتق نسمة) وأكثر مصادر العامّة هكذا، وهو كما ترى. اُنظر: مجمع الزوائد: ج8، ص156، المعجم الأوسط: ج8، ص283، وغيره.
[342] الكهف: آية81.
[343] اُنظر: الكافي: ج6، ص6، ح11. تفسير العيّاشي: ص336، ح10. وسائل الشيعة: ج21، ص364، ح4. بحار الأنوار: ج13، ص311، ح26، عن تفسير العياشي.
[344] اُنظر: الكافي: ج، ص6، ح8. ثواب الأعمال: ص201. مَن لا يحضره الفقيه: ج3، ص481، ح4692. تحف العقول: ص382.
[345] فقد رُوي عن أبي عبد الله الصّادق× أنّه قال: «إنّ النبي’ كان يكثر من تقبيل فاطمة‘...» المحتضر: ص238، ح318. نظم درر السُمطين: ص177. أمالي الشيخ الصدوق: ص522، ضمن حديث2. (تقبيله’ للحسن والحسين÷).
[346] الأحزاب: آية21.
[347] المجموع: ج4، ص639. روضة الواعظين: ص639. وفيه (يُقَبِّلُ الحسنَ بنَ عليٍّ). وسائل الشيعة: ج21، ص485، ح4. بحار الأنوار: ج43، ص282 ـ 283.
[348] الكافي: ج6، ص18، ح2، عن أمير المؤمنين× «سمّوا أولادكم قبل أن يولدوا... وقد سمى رسول الله’ محسناً قبل أن يولد».
[349] المصدر نفسه: ج6، ص18، ح3. التهذيب: ج7، ص437، ح9. وسائل الشيعة: ج21، ص388 ـ ص389، ح1، عن الكافي.
[350] المصدر نفسه: ج6، ص19، ضمن ح10. وسائل الشيعة: ج21، ص389، ح2. عدّة الداعي: ص78. بحار الأنوار: ج101، ص131، ح29.
[351] المحتضر: ص219. جامع أحاديث الشّيعة: ج12، ص302. مفاتيح الجنان: ص625.
[352] الكافي: ج6، ص19، ح6. التهذيب: ج7، ص438، ح11. وسائل الشيعة: ج21، ص393، ح2، وص394، ح5، وفيه (ثلاث بنين). بحار الأنوار: ج17، ص29، ح8، عن الكافي.
[353] المصدر نفسه: ج6، ص19، ح8. تهذيب الأحكام: ج17، ص29، ح8، عن الكافي.
[354] المصدر نفسه: ج6، ص20، ح12. وسائل الشيعة: ج21، ص393، ح3. بحارالأنوار: ج101، ص131، ح26، روى قطعة فيه.
[355] زهر الربيع: ص522. واُنظر: الجَمل: ص159 ـ 160.
[356] القلم: آية1.
[357] الكافي: ج1، ص35، ح2. مستطرفات السرائر: ص595. الفصول المهمّة: ج1، ص465، ح1.
[358] اُنظر: السيرة الحلبيّة: ج2، ص451.
[359] فقد روي عن رسول الله’ أنه قال: «خير نسائكم العفيفة». دعائم الإسلام: ج2، ص197، ح722. ومثله في مستدرك الوسائل: ج14، ص159، ح1. وفي مكارم الأخلاق: ص202. عنه’ قال: «شوهاء ولود خيرٌ من حسناء عقيم».
وأمّا كونها كريمة الأصل فقد أفتى مجموعة من الفقهاء ـ قديماً وحديثاً ـ باستحباب كونها كريمة الأصل. اُنظر: العروة الوثقى: ج5، ص479، مع تعليقات لعدّة من الفقهاء العظام (رحمهم الله).
وفي نهاية المرام: ج1، ص39، قال: «وأمّا استحباب اختيار كريمة الأصل، فيمكن أن يُستدلّ عليه بما رُوي عن النبي’ أنّه قال: أيّها الناس، إيّاكم وخضراء الدّمن. قيل: يا رسول الله، وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. وفُسّر كرم الأصل: بأن يكون أبواها مُسلمين، أو مؤمنين، أو صالحين، أو لا يكون أصلُها من زنا».
[360] فقد روي عن النبي الأكرم’ أنه قال: «... إنَّ الأبكار بمنـزلة الثمر على الشجر، إذا أدرك ثمارها فلم تجتنِ أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار...» اُنظر: وسائل الشيعة: ج20، ص61، ح2.
[361] ويدلَّ عليه ما روي عن الإمام الحسين× أنه قال: «اللهم اشهد، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك’، وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إليه...» اللهوف: ص67. بحار الأنوار: ج45، ص42.
[362] أوردها العلاّمة المجلسي& في بحار الأنوار: ج98، ص186.
[363] مجمع مصائب أهل البيت^: ج1، ص390 ـ ص428.
[364] هذه الأبيات من قصيدة رائعة للسيد جعفر الحلي& والّتي مطلعها:
أدرك تراتك أيُّها الموتور فلكم بكلِّ يدٍ دمٌ مهدور
وقد تقدّمت ترجمته في المحاضرة الخامسة من هذا الكتاب فراجع.
[365] هود: آية114.
[366] تفسير العياشي: ج2، ص161، ح73. تفسير البرهان: ج4، ص151، ح10. تفسير نور الثقلين: ج2، ص399 ـ 400، ح234.
[367] النساء: آية48.
[368] الزمر: آية53.
[369] آل عمران: آية135.
[370] تفسير أبي حمزة الثمالي: ص203. تفسير العياشي: ج2، ص161 ـ 162، ح74. تفسير مجمع البيان: ج5، ص346. التفسير الصافي: ج2، ص476. تفسير نور الثقلين: ج2، ص401 ـ 402، ح237. بحار الأنوار: ج79، ص220، ح41، عن مجمع البيان والعياشي وأبي حمزة الثمالي.
[371] شرح نهج البلاغة: ج20، ص313، رقم 598.
[372] هود: آية112.
[373] التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج18، ص73.
[374] تفسير الميزان: ج11، ص58.
[375] شرح نهج البلاغة: ج4، ص34، رقم 136. الكافي: ج3، ص265، ح6. دعائم الإسلام: ج1، ص133 ورواه عن النبي الأكرم’. عيون أخبار الرضا: ج2، ص10، ح16. مَن لا يحضره الفقيه: ج1. ص210، ح637، كلاهما عن الإمام الرضا×، وفي ج4، ص416، ح5904، عن الإمام الصادق×، وسائل الشيعة: ج4، ص43، ح1، عن الإمام الرضا×. بحار الأنوار: ج75، ص203، ح41، عن الإمام الصادق×.
[376] العنكبوت: آية45.
[377] البداية والنهاية: ج10، ص220.
[378] ففي الكافي الشريف: ج3، ص268، ح4، عن أبي بصير قال: «سمعت أبا جعفر× يقول: كل سهوٍ في الصلاة يُطرح منها غير أنَّ الله تعالى يُتم بالنوافل، إن أول ما يُحاسب به العبد الصلاة، إن قُبلت قبل ما سواها...» الحديث ومثله في التهذيب: ج2، ص239، ح15. وسائل الشيعة: ج4، ص108، ح2. بحار الأنوار: ج7، ص267، ح33، عن التهذيب، وفي مواضع أُخرى أيضاً.
[379] اُنظر: شرح نهج البلاغة: ج2، ص124 ـ 125. الدرجات الرفيعة: ص160. الغارات: ج2، ص936. بحار الأنوار: ج42، ص112 ـ 113، عن شرح النهج.
[380] اُنظر: الخرائج والجرائح: ج2، ص846 ـ 847، ح62، عنه بحار الأنوار: ج44، ص298، ح3. العوالم (الإمام الحسين×): ص350، ح1، عن الخرائج أيضاً.
[381] اُنظر: معالي السبطين: ج1، ص340 ـ 342.
[382] اُنظر: بحار الأنوار: ج45، ص47. لواعج الأشجان: ص181 ـ 182.
[383] القصيدة للسيد جعفر الحلي&، وقد تقدَّمت ترجمته في المحاضرة الخامسة.
[384] بحار الأنوار: ج75، ص126، ح7.
[385] النحل: آية125.
[386] بحار الأنوار: ج47، ص349 ـ 350، ح50.
[387] وهذا الجواب هو أحد الأجوبة في مقام دفع إشكالات عديدة يتراءى منها ثبوت الذنوب والمعاصي للمعصومين^، وقد اختاره الشّيخ الصّدوق& في كتابه الاعتقادات في دين الإمامية: ص87، والسّيد المرتضى علم الهدى& في تنـزيه الأنبياء: ص167، ومرويٌ عن ابن عبّاس أنّه قال: «نـزل القُرآن بإياكِ أعني واسمعي يا جارة». اُنظر: مجمع البيان: ج7، ص465. عوالي اللئالي: ج4، ص115، ح179.
[388] الشعراء: آية79.
[389] البقرة: آية60.
[390] الذاريات: آية58.
[391] الزمر:آية67.
[392] الكهف: آية44.
[393] البقرة: آية120.
[394] الأنعام: آية51.
[395] البقرة: آية77.
[396] البقرة: آية235.
[397] المائدة: آية97.
[398] طه: آية7.
[399] المُلاءة أو المُلاة: الإزار. اُنظر: النهاية في غريب الحديث: ج2، ص404.
[400] تفسير القمي: ج1، ص342. بحار الأنوار: ج12، ص225، ح3. والآية (25) من سورة يوسف.
[401] التحريم: آية6.
[402] ق: آية19.
[403] السجدة: آية11.
[404] نهج البلاغة: ج1، ص221، خطبة 112، في ملك الموت. تفسير نور الثقلين: ج4، ص225، ح19. بحار الأنوار: ج6، ص143، ح9، عن النهج.
[405] نهج البلاغة: ج4، ص83، رقم 356، تفسير نور الثقلين: ج5، ص356، ح42. بحار الأنوار: ج67، ص146، وج100، ص37، ح80.
[406] الزخرف: آية77.
[407] أمالي الشيخ الصدوق: ص536. روضة الواعظين: ص58. بحار الأنوار: ج18، ص335.
[408] كمال الدين وتمام النعمة: ص283. مدينة المعاجز: ج3، ص433. بحار الأنوار: ج43، ص248، ح24، عن كمال الدين.
[409] اُنظر: كتاب الأخلاق الحسينية: ص291 ـ 292.
[410] القصيدة للشيخ عبد الحسين الأعسم& كما قال السيد الأمين& في الدرّ النضيد: ص332. وقد تقدَّمت ترجمته في المحاضرة الثانية من هذا الكتاب فراجع.
[411] آل عمران: آية61.
[412] شرح إحقاق الحقّ: ج9، ص81، عن الصواعق: ص154 (ط عبد اللطيف بمصر). واُنظر: تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص432. ينابيع المودّة: ج2، ص344. بحار الأنوار: ج35، ص266 ـ 267، عن الصواعق.
[413] اقتباس من قوله تعالى: (ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ) الإنسان: آية19.
[414] نقلنا هذا الكلام المسبوك من كتاب الكلمة الغرّاء في تفضيل الزهراء‘ المطبوع في ذيل الفصول المهمّة في تأليف الأُمّة: ص197 ـ ص198. والكتابان من تأليف فخر الشّيعة السيّد عبد الحُسين شرف الدين&.
[415] تفسير الكشّاف: ج1، ص370.
[416] اُنظر: فهرست منتجب الدين: ص432. تفسير البحر المحيط: ج2، ص503. بحار الأنوار: ج21، ص283.
[417] التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج8، ص86.
[418] اُنظر: الكملة الغرّاء في تفضيل الزهراء: ص201 ـ 202.
[419] التوبة: آية120.
[420] ا اُنظر: هامش الكلمة الغرّاء: ص202.
[421] المناقب: ص108، ح115، العمدة: ص188، ح288. واُنظر: سنن الترمذي: ج5، ص301، ح3808. فتح الباري: ج7، ص60. السنن الكبرى: ج5، ص107 ـ 108، ح8399. خصائص أمير المؤمنين: ص47 ـ 48. خصائص الوحي المبين: ص126 ـ 127. شواهد التنـزيل: ج2، ص35 ـ 36، ح656. تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص111 ـ 112. أُسد الغابة: ج4، ص25 ـ 26. الإصابة: ج4، ص468. نهج الإيمان: ص347 ـ 348. بحار الأنوار: ج37، ص264ـ 265، ح34، وج39، ص315 ـ 316، ح12.
[422] اُنظر: تفسير الكشّاف: ج1، ص433.
[423] تفسير القُمّي: ج1، ص104.
[424] التوبة: آية32.
[425] الأبيات ـ ما عدا الرابع ـ من قصيدة رائعة للشيخ عبد العظيم الربيعي& كما في ديوانه المطبوع الموسوم بـ(ديوان الربيعي صفحة 237)، وأمّا البيت الرابع فإنّي سمعته من أُستاذي المرحوم الشيخ محمّد سعيد المنصوري وكأنّه من نظمه&.
وأمّا الشيخ الربيعي فقد جاء في ترجمته في مقدّمة كتابه البديع (سياسة الحُسين ×) بقلم أخينا الخطيب المُبدع الشيخ هادي الهلالي (حفظه الله) ما ملخّصه: «هو الشيخ عبد العظيم بن التقي النقي الشيخ حسين بن الشيخ علي... البحراني الربيعي، عالم جليلٌ، وأديب كبيرٌ، وكاتب ضليعٌ وشاعر مبدع، ولد في عبادان سنة 1323 هجرية، ونشأ نشأةً صالحة فقرأ المبادئ الأوّلية لدى والده الذي كان من العلماء الأجلاّء المشهود لهم بغزارة العلم وسعة الإطّلاع، إلى جانب ورعه وصلاحه وتحرّجه في الدين... يمّم وجهه صوب عاصمة العلم والدين والأدب النجف الأشرف... بدأ بـالاختلاف على أساتذة مُبرّزين وفضلاء معروفين وفقهاء مرموقين كان من بينهم (آية الله أبو الحسن الأصفهاني)، ثمّ كرّ راجعاً إلى مسقط رأسه...
للشيخ الربيعي مؤلفات كثيرة، منها (وفاة الإمام الرضا×)، ألفية الربيعي في النحو، سياسية الحسين، المنظومة في المنطق، المنظومة في البلاغة، المنظومة في العقائد... توفاه الله تبارك وتعالى في الثامن من شهر جمادى الأُولى سنة 1399 هجرية».
[426] النساء: آية149.
[427] الأخلاق والآداب الإسلامية: ص154.
[428] الحجرات: آية9.
[429] البقرة: آية237.
[430] النور: آية22.
[431] نهج البلاغة: ج4، ص4، ح11. عيون الحكم والمواعظ: ص132. المناقب (الخوارزمي): ص376. وسائل الشيعة: ج12، ص171، ح8. الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج1، ص548. بحار الأنوار: ج68، ص427.
[432] تفسير الأمثل: ج3، ص510 ـ 511. بتصرّف يسير.
[433] مقطع من دعاء الافتتاح، اُنظر: تهذيب الأحكام: ج3، ص108. إقبال الأعمال: ج1، ص138. المصباح (الكفعمي): ص578، عنه بحار الأنوار: ج24، ص166، ح14.
[434] النساء: آية148.
[435] البقرة: آية271.
[436] تفسير الميزان: ج5، ص124.
[437] بحار الأنوار: ج74، ص180. والآية40 من سورة الشورى.
[438] نهج البلاغة: ج4، ص14، ح52. أمالي الشيخ الصدوق: ص73. معاني الأخبار: ص196. مَن لا يحضره الفقيه: ج4، ص396. كنـز الفوائد: ص138. عيون الحكم والمواعظ: ص120. جواهر المطالب: ص141، ح15. أعلام الدين: ص303. وسائل الشيعة: ج12، ص171، ح9. بحار الأنوار: ج68، ص427، ح76.
[439] مجمع الزوائد: ج8: ص82.
[440] الكافي: ج2، ص108، باب العفو ح5. مشكاة الأنوار: ص403. التفسير الصافي: ج1، ص381. تفسير نور الثقلين: ج4، ص585، ح123. وسائل الشيعة: ج12، ص169 ـ 170، ح2. بحار الأنوار: ج68، ص401، ح5، عن الكافي.
[441] كنـز الفوائد: ص56. بحار الأنوار: ج72، ص357.
[442] تنبيه الخواطر: ج2، ص120.
[443] المصدر نفسه.
[444] الأخلاق والآداب الإسلامية: ص157.
[445] القصيدة للشيخ محمد بن شريف بن فلاح الكاظمي&، قال عنه السيد جواد شبّر& في أدب الطفّ: «الشيخ محمد شريف بن فلاح الكاظمي نـزيل الغري، ولد في الكاظمية ونشأ فيها، ثمَّ هاجر إلى النجف وقرأ العلوم فيها في الربع الأخير من القرن الثاني عشر للهجرة، وكان من المشاهير في العلم والأدب واللامعين من بين أقرانه، له اطّلاع بجملة من العلوم، ومن أهل الكرامات الباهرة، معاصراً للشيخ مهدي الفتوني العاملي النجفي المتوفى سنة 1183 هـ، وللسيد محمد مهدي الطباطبائي المعروف ببحر العلوم، وللشيخ الأكبر الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء، وللشيخ أحمد النحوي، وكان على جانب عظيم من التقى والورع والصلاح، تنسب إليه كرامات الصلحاء الأبرار.
وله القصيدة الدالية في مدح أميرالمؤمنين× وإنّه ألقاها في الحرم أمام القبر الشريف، وسقط عليه القنديل الذهبي المعلّق، فأُخذ من يده وعُلق، فوقع عليه مرة ثانية فأخذه، والقصيدة أولها:
1. أبا حسن ومثلك من ينادى لكشف الضرّ والهول الشديد
توفي& سنة1220 هـ». أدب الطفّ: ج6، ص124ـ 126.
[446]النساء: آية59
[447]آيات منتخبة: ص126
[448] تفسير الميزان: ج4، ص387
[449]النساء: آية80.
[450] الحشر: آية7.
[451]الكافي: ج1، ص53. روضة الواعظين: ص211. الإرشاد: ج2، ص186. الخرائج والجرائح: ج2، ص895. وسائل الشيعة: ج27، ص83، ح26. بحار الأنوار: ج2، ص178 ـ 179، ح28.
[452] النساء: آية141.
[453] اُنظر: تفسير الأمثل: ج3، ص286ـ ص291.
[454] تفسير الأمثل: ج3، ص286 ـ 291.
[455]التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج10، ص144.
[456]المصدر السابق.
[457]محاضرات في الإلهيات: ص374.
[458]تفسير الأمثل: ج3، ص294 ـ ص295، نقلاً عن ينابيع المودّة والبحر المحيط.
[459] اُنظر: تفسير البرهان: ج2، ص252 ـ 265.
[460] الجران: مقدَّم العنق من مذبح البعير، أي: منحره. كتاب العين: ج6، ص104.
[461] اُنظر: الكافي: ج1، ص467، ح2. بحار الأنوار: ج46، ص148، ح4.
[462]مجمع مصائب أهل البيت^: ج3، ص123 ـ ص124.
[463] القصيدة للشيخ حسّون الحلي&، قال عنه السيّد جواد شبّر& في أدب الطّف: «هو الشيخ حسون (حسين) بن عبد الله بن الحاج مهدي الحلي من مشاهير الخطباء في عصره. أديب شاعر معروف. ولد في الحلّة عام 1250 هـ، ونشأ بها وعرف بالخطابة فكان من أشهر مشاهيرها، وذاع صيته في الشعر فكان من أعلام الشعراء فيها، وكان مرموق الشخصية نابه الذكر حميد الخصال يحترمه الكبير والصغير ويعظمه العالم والجاهل ويهواه الأعيان والوجوه، مستقيم السيرة طيب السريرة كريم الطبع طاهر القلب مرح الروح، من أعلام النسّاك وبارزي الثقاة، ولقد أعربَ عن منـزلته الشاعر الخالد السيد حيدر الحلي عند تقدمته لتقريضه كتابه (العقد المفصل)، فقال: هو الذي تقتبس أشعة الفضل من نار قريحته.
توفي رحمه الله بالحلّة في العشر الأواخر من شهر رمضان عام 1305 هـ، ونُقل جثمانه إلى النجف ودُفن بها، وخلّف ولداً اسمه الشيخ علي، توفي بعده بثلاثين عاماً. ورثاه فريق من شعراء عصره بقصائد مؤثرة دلّت على سمو مكانته في نفوسهم... ». أدب الطف: ج8، ص45 ـ 47.
[464] البقرة: آية42.
[465] الخصال: ص236، باب الأربعة. وورد قريباً منه في نهج البلاغة: ج2، ص24.
[466] الإسراء: آية36.
[467] مسند زيد بن علي×: ص389. نهج السعادة: ج3، ص291.
[468] الكافي: ج2، ص214، باب ترك دُعاء الناس، ح5، عنه بحار الأنوار: ج65، ص210، ح15.
[469] الطومار: (الصحيفة) جمعه طوامير.
[470] تفسير البرهان: ج1، ص202 ـ 203، ذيل آية 42 من سورة البقرة، ح1.
[471] الأخلاق والآداب الإسلامية: ص606 ـ 608.
[472] هامش الإلهيات: ص256.
[473] التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): ج3، ص43.
[474] المعجم الصغير: ج1، ص255. الجامع الصغير: ج2، ص177. كنـز العمال: ج11، ص603.
[475] أمالي الشيخ الطوسي: ص479. المستدرك على الصحيحين: ج3، ص124.
[476] صحيح البخاري: ج3، ص207. مسند أحمد: ج2، ص164. المستدرك: ج2، ص149.
[477] معاني الأخبار: ص35. الاحتجاج: ج1، ص268. بحار الأنوار: ج33، ص7،ح364.
[478] نهج البلاغة: ج1، ص85، و ج4، ص45، ح198. دعائم الإسلام: ج1، ص393. خصائص الأئمّة: ص113. مناقب آل أبي طالب: ج2، ص369. العُمدة: ص330. فتح الباري: ج12، ص251. تاريخ الطبري: ج4، ص53. وقعة صفّين: ص489. الدُّرُّ النظيم: ص334. بحار الأنوار: ج32، ص532، وج33، ص357، ح590 عن النهج، وج72، ص357.
[479] مجمع مصائب أهل البيت^: ج2، ص34 ـ 35.
[480] القصيدة للشاعر الشيخ محمد رضا الأزري&، قال عنه السيّد جواد شبّر& في أدب الطف: «الشيخ محمد رضا الأزري ولد سنة 1162 وتوفي 1240 في بغداد، درس العلوم العربية على أخيه الشيخ يوسف الأزري وعلى غيره من فضلاء عصره، وولع بحفظ القصائد الطوال من شعر العرب فقد رووا عنه أنّه كان يحفظ المعلّقات السبع وقسماً كبيراً من أشعار الجاهلية والإسلام، مضافاً إلى الخطب والأحاديث المروية عن العرب. أهم شعره في رثاء أهل البيت، وقد حدثت في زمانه واقعة الوهابيين المعروفة في التاريخ حينما احتلّوا كربلاء ونهبوها وقتلوا من أهلها ما يزيد على خمسة آلاف نسمة، وذلك سنة 1216 فنظم على أثرها ثلاث قصائد تشتمل على مائتين وستين بيتاً، ذكر بها الواقعة المذكورة وختم كلاً منها بتأريخ، وإذا لاحظنا تواريخ قصائده رأينا أكثرها نظمت بعد وفاة أخيه الشيخ كاظم الأزري... وللشيخ محمد رضا الأزري يصف بطولة العباس بن أمير المؤمنين يوم كربلاء:
|
أو مـا أتـاك حديث وقعة كربلاء |
|
أنَّى وقـد بـلغ الـسماء
قتامها |
أدب الطفّ: ج6، ص263.
[481] الشورى: آية36.
[482] النهاية في غريب الحديث: ج5، ص221.
[483] الملك: آية15.
[484] آل عمران: آية159.
[485] علل الترمذي: ص417. مشكاة الأنوار: ص551. فتح الباري: ج3، ص304. صحيح ابن حبّان: ج2، ص510.
[486] معاني الأخبار: ص261.
[487] روضة الواعظين: ص426. واُنظر: الأخلاق والآداب الإسلامية: ص546 ـ 547.
[488] الطلاق: آية3.
[489] الأخلاق والآداب الإسلامية: ص547.
[490] مسند أحمد: ج4، ص229. صحيح مسلم: ج8، ص156.
[491] تفسير الأمثل: ج15، ص546 ـ 547.
[492] مجمع مصائب أهل البيت^: ج2، ص126 ـ 129، مع تصرّف يسير في العبارة.
[493] القصيدة للسيد رضا الهندي& وقد تقدّمت ترجمته في المحاضرة التاسعة من هذا الكتاب فراجع.
[494] أمالي الشيخ الصدوق: ص65، ح5. مشكاة الأنوار: ص213. الدرّ المنثور: ج5، ص165. وسائل الشيعة: ج15، ص218، ح7. بحار الأنوار: ج67، ص384، ح39، عن الأمالي.
[495] السجدة: آية16.
[496] كنـز العمال: ج3، ص144، ح5894.
[497] فاطر: آية28.
[498] بحار الأنوار: ج67، ص393، ح64.
[499] تنبيه الخواطر: ج1، ص232. واُنظر: الأخلاق والآداب الإسلامية: ص461.
[500] بحار الأنوار: ج67، ص191.
[501] المصدر نفسه: ج4، ص50.
[502] الإرشاد: ج2، ص229 ـ 230. روضة الواعظين: ص214. الثاقب في المناقب: ص456، ح2. الخرائج والجرائح: ج2، ص649، ح1. مدينة المعاجز: ج6، ص313، ح96. كشف الغمّة: ج3، ص19. بحار الأنوار: ج48، ص57، ح67، عن المناقب والإرشاد والخرائج.
[503] الكافي: ج2، ص68، ح2. وسائل الشيعة: ج15، ص220، ح6. بحار الأنوار: ج67، ص355، ح2، عن الكافي.
[504] فاطر: آية 28.
[505] شجرة طوبى: ج2، ص371، عن الأنوار النعمانية.
[506] مجمع مصائب أهل البيت^: ج2، ص121 ـ 123.
[507] للشاعر محمّد تقي الجواهري&، قال عنه صاحب كتاب شعراء الغري: «هو الشيخ محمد تقي بن الشيخ عبد الرسول بن الشيخ شريف بن الشيخ عبد الحسين بن الشيخ الأكبر محمد حسن صاحب جواهر الكلام، عالمٌ فاضلٌ، وأديب بارع، وشاعر مطبوع، ولد في النجف 25 جمادى الأولى عام 1341 هـ، ونشأ بها على والده الحجة الفقيه، فقرأ عليه المقدِّمات وعني بتوجيهه وتدريسه، فنال العلم الجمّ على صغره، واختلف على حلقات أعلام عصره، كحلقة والده في الفقه، وفي الأصول على حلقة السيد أبو القاسم الخوئي، والشيخ ميرزا باقر الزنجاني، والمترجم له شاب يحمل عقل الشيوخ، وإنسان يتّصف بصفات الإنسان الصحيح.
له من المؤلفات: (غاية المأمول من علم الأصول) خصّ فيه بحث أستاذه السيد الخوئي ويقع في جزءين، (مدارك العروة الوثقى في الفقه الاستدلالي) وصل به إلى باب الوضوء، (منظومة في فروع العلم الإجمالي استدلالاً) قد أكمل منه ستة عشر فرعاً» كتاب شعراء الغري: ج7، ص337.
[508] النساء: آية31.
[509] الكهف: آية49.
[510] سورة الزمر: 53.
[511] تفسير الميزان: ج4، ص324 ـ 325.
[512] نسبه الطبرسي& في مجمع البيان ـ على ما حكي عنه في تفسير الأمثل ـ إلى علماء الشيعة، ونسبه العلاّمة الطباطبائي في حاشية تفسيره إلى الغزالي.
[513] اُنظر: مجمع البحرين: ج4، ص10.
[514] الكافي: ج2، ص288. مشكاة الأنوار: ص201. تفسير جوامع الجامع: ج1، ص393. تفسير مجمع البيان: ج2، ص395. التفسير الصافي: ج1، ص382. تفسير نور الثقلين: ج1، ص394، ح368. وسائل الشيعة: ج15، ص338، ح3. بحار الأنوار: ج85، ص30.
[515] نهج البلاغة: ج4، ص81، ح348. وسائل الشيعة: ج15، ص312، ح6. شرح أصول الكافي: ج1، ص196. مستدرك الوسائل: ج11، ص350، ح12.
[516] النازعات: آية27 ـ آية29.
[517] الأحزاب: آية30.
[518] ثواب الأعمال: ص223. وسائل الشيعة: ج15، ص304 ـ 305، ح22. أعلام الدين: ص401. بحار الأنوار: ج6، ص36، ح57.
[519] تفسير الأمثل: ج3، ص205 ـ 207.
[520] الأخلاق والآداب الإسلامية: ص731 ـ 732.
[521] مجمع مصائب أهل البيت^: ج2، ص133 ـ 134.
[522]للشاعر محمد التهامي المصري&، قال عنه كامل سليمان الجبوري في كتابه (معجم الشعراء): ج4، ص356ـ ص357: «محمد التهامي، سيّد أحمد ولد في قرية الدالاتون محافظة المنوفية ـ مصر سنة 1920، حصل على ليسانس في القانون والاقتصاد من كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية 1947، اشتغل بالمحاماة والصحافة والإعلام، فكان مديراً لتحرير صحيفة الجمهورية 1953ـ 1958... اشترك في أكثر من ثلاثين مؤتمراً ومهرجاناً شعرياً.
نشر ديوانه الشعري الأول وهو طالب بالمرحلة الثانوية، من دوواينه الشعرية (أغنيات لعشّاق الوطن) و(أنا مسلم) شعر إسلامي... نال الميدالية الذهبية لشعر معركة بور سعيد 1956... »
[523]الحديد: آية25.
[524] اُنظر: الإلهيات: ص247.
[525] المصدر نفسه: 257.
[526] تفسير الأمثل: ج18، ص71.
[527]شرح التجريد: ص465.
[528]كما جاء في قوله تعالى: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ). النمل: آية40.
[529]الإلهيات: ص259.
[530]القليب: البئر، والمراد منه قليب بدر، طـُرح فيه نيف وعشرون من أكابر قريش.
[531]نهج البلاغة: ج2، ص158 ـ 160، ذيل خطبة 192 المُسمّاة بالقاصعة. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص416. إعلام الورى: ج1، ص75. الدرّ النظيم: ص134. نهج الإيمان: ص533، بحار الأنوار: ج14، ص477، وج17، ص390، ح59، عن إعلام الورى والنهج، وج38، ص321.
[532]إعلام الوری: ج1، ص74 ـ 88.
[533]الصف: آية6.
[534]البقرة: آية146.
[535]الأعراف: آية157.
[536]الإلهيات: ص264ـ 265.
[537]هامش الإلهيات: ص256.
[538]الكامل في التاريخ: ج2، ص95 ـ 96، حوادث السنة السادسة للهجرة. تاريخ الطبري: ج2، ص290ـ 291.
[539] تفسير الميزان: ج19، ص171 ـ 172 (بتصرّف).
[540]للشاعر المسمی (ابن الزبعری)، وهو من ألدِّ أعداء رسول الله’، واسمُه عبد الله بن الزبعرى السّهمي، وهذ الأبيات قالها ـ لعنه الله ـ في معركة أُحد، وله مواقف سيئة مع رسول الله’ وسائر المسلمين. اُنظر: بحار الأنوار: ج35، ص126.
[541] الروم: آية10.
[542] آل عمران: آية178.
[543] اللهوف: ص105 ـ 106. الاحتجاج: ج2، ص35. مثير الأحزان: ص80. بلاغات النساء: ص21. بحار الأنوار: ج45، ص133. العوالم (الإمام الحسين×): ص403.
[544] القصيدة للسيد هاشم الستري البحراني&، قال عنه في أنوار البدرين ـ ص 233 ـ: «السيد النجيب الأديب السيد هاشم المعروف بالصياح& الستري البحراني كان& أديباً شاعراً له يد طولى في علم التجويد، ولهذا يلقب بالقارئ، سمعت من شيخنا الثقة العلاّمة المرحوم الصالح الشيخ أحمد ابن المقدّس الشيخ صالح+ أنّ له كتاباً في القراءة سماه (هداية القارئ إلى كلام البارئ)، وله القصيدة الغرّاء التي أولها:
قم جدد الحزن في العشرين من صفر ففيه ردت رؤوس الآل للحفر
وهي مشهورة».
[545] مجمع مصائب أهل البيت^: ج2، ص160 ـ 162.
[546] تهذيب الأحكام: ج6، ص52، باب زيارة الحسين×، ح37. روضة الواعظين: ص195، وفيه بدل الخمسين (إحدى والخمسين). ومثله المزار (الشيخ المفيد): ص53، ح1. والمزار (ابن المشهدي): 352، ح1. وإقبال الأعمال: ج3، ص100. وعوالي اللئالي: ج4، ص37، لكن رواه عن الإمام الصادق×. وسائل الشيعة: ج14، ص478، ح1، عن التهذيب. بحار الأنوار: ج82، ص75، ح7، وج95، ص348، ح1، عن الإقبال، وج98، ص106، ح17، عن التهذيب، وص329، ح1، عن مصباح الزائر.
[547] أمالي الشيخ الصدوق: ص190. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص238. إقبال الأعمال: ج3، ص28. بحار الأنوار: ج44، ص283، ح17، عن الأمالي. العوالم (الإمام الحسين×): ص538، عن الأمالي أيضاً.
[548] مناقب ابن شهر آشوب: ج2، ص170، وعنه بحار الأنوار: ج42، ص308، ح9.
[549] كامل الزيارات: ص167، ح8، باب بكاء جميع خلق الله على الحسين×. مدينة المعاجز: ج4، ص166 ـ ص167، ح243. بحار الأنوار: ج45، ص205 ـ 206، ح13، عن كامل الزيارات. العوالم (الإمام الحسين×): ص462.
[550] مقتل الحسين× للسيد عبد الرزاق المقرّم: ص365.
[551] اُنظر: كامل الزيارات: ص183، باب بكاء السماء والأرض على الحسين×. واُنظر: مقتل الحسين× للمقرّم: ص365.
[552] كامل الزيارات: ص116، ح11، باب حبُّ رسول الله’ للحسن والحسين÷.
[553] مقتل الإمام الحسين×، السيد المقرّم: ص371.
[554] التهذيب: ج6، ص52، باب زيارة الحسين×، ح27.
[555] مصباح المتهجّد: ص788.
[556] اُنظر: منتهى المطلب: ج2، ص892.
[557] اُنظر: إقبال الأعمال: ج3، ص100.
[558] اُنظر: بحار الأنوار: ج95، ص348، ح1.
[559] اُنظر: الحدائق الناضرة: ج17، ص435.
[560] اُنظر: مفاتيح الجنان: ص541.
[561] اُنظر: مسارّ الشيعة (ضمن مجموعة نفيسة): ص27، وص63.
[562] اُنظر: تذكرة الفقهاء: ج1، ص403.
[563] اُنظر: تحرير الأحكام: ج1، ص131.
[564] اُنظر: كتاب مقتل الحسين× للسيد المقرّم: ص372، ولم أعثر على كتاب تقويم المحسنين.
[565] بشارة المصطفى: ص125ـ 126، عنه بحار الأنوار: ج65، ص130ـ 131، ح61.
[566] معالي السبطين: ج2، ص197.
[567] القصيدة للسيد صالح الحلّي&، وقد تقدّمت ترجمته في المحاضرة العاشرة من هذا الكتاب فراجع.
[568] الشورى: آية30.
[569] الروم: آية41.
[570] الأعراف: آية96.
[571] تفسير الميزان: ج18، ص59 ـ 60. بتصرّف يسير.
[572] تفسير مجمع البيان: ج9، ص53.
[573] الخصال: ص616، حديث الأربعمائة، وعنه بحار الأنوار: ج70، ص350، ح47. والآية في سورة الشورى: آية30.
[574] اُنظر: كيمياء المحبّة: ص138.
[575] تفسير الأمثل: ج15، ص539 ـ ص540.
[576] النحل: آية61.
[577] تفسير الميزان: ج18، ص71.
[578] اُنظر: معاني الأخبار: ص270. الكافي: ج2، ص448، ح1. عُدّة الداعي: ص199. وسائل الشيعة: ج16، ص281 ـ ص282 ضمن حديث 8. بحار الأنوار: ج70، ص375، ح12، عن المعاني.
[579] اُنظر: الكافي: ج2، ص448، ح1. علل الشرائع: ج2، ص584، ح27. الاختصاص: ص238. معاني الأخبار: ص269، ح1. وسائل الشيعة: ج16، ص274، ح3. بحار الأنوار: ج70، ص374، ح11، عن العلل، وج101، ص373، ح19، عن العلل أيضاً.
[580] العلق: آية6 ـ 7.
[581] البقرة: آية214.
[582] الإلهيات: ص178 ـ 180.
[583] تفسير الأمثل: ج15، ص536.
[584] من دُعاء النُدبة، اُنظر: بحار الأنوار: ج99، ص107.
[585] كامل الزيارات: ص213، باب بكاء عليّ بن الحسين÷، ح1. أمالي الشيخ الصدوق: ص204. الخصال: ص272 ـ 273، ضمن حديث 15. روضة الواعظين: ص170. مكارم الأخلاق: ص316. مناقب آل أبي طالب: ج3، ص303. كشف الغُمّة: ج2، ص121. بحار الأنوار: ج43، ص155، ح1، عن الخصال وج46، ص108، ح1، عن المناقب، وج79، ص86 ـ 87، ح33، عن الخصال.
[586] مجمع مصائب أهل البيت^: ج1، ص103ـ 105.
[587] علّها: جرعاتها.
[588] القصيدة للسيد جعفر الحلي& رياض المدح والرثاء: ص221 ـ 223. وهي قصيدة طويلة إقتطعنا بعضها لا على نحو الترتيب، بل على نحو ما يناسب المقام، والله المسدد للصواب، وقد تقدّمت ترجمة السيد في المحاضرة الخامسة، فراجع.
[589] بحار الأنوار: ج75، ص229، ح9.
[590] عيون الحكم والمواعظ: ص182.
[591] عيون الحكم والمواعظ: ص417.
[592] أمالي الشيخ الصدوق: ص72، ح31. معاني الأخبار: ص366. روضة الواعظين: ص379. مشكاة الأنوار: ص72. وسائل الشيعة: ج15، ص361، ح14. بحار الأنوار: ج72، ص28، ح16، عن معاني الأخبار. ويوجد في المصادر اختلاف يسير، كالاختلاف في كلمة (يرفعون حجراً) أو (يربعون) أو (يتشايلون) أو (يريعون) بمعنى يرفعون فراجع.
[593] شرح نهج البلاغة: ج3، ص268. شرح أصول الكافي: ج1، ص194.
[594] عوالي اللئالي: ج1، ص432. مسند أحمد: ج3، ص19. سنن ابن ماجة: ج2، ص1329. سنن أبي داود: ج2، ص325، ح4344. تفسير التبيان: ج2، ص422. تفسير مجمع البيان: ج2، ص263.
[595] مواقف الشيعة: ج3، ص265.
[596] آل عمران: آية123.
[597] اُنظر: مناقب ابن شهر آشوب: ج1، ص165، وما بعدها.
[598] الأحزاب: آية25.
[599] اُنظر: بحار الأنوار: ج42، ص274. الإمامة والسياسة: ج1، ص179- 182.
[600] معنى (وصابه) هنا أي أنّ الرسول الأعظم’ وصّى بأمير المؤمنين×؛ وذلك في مواطن عديدة لا يسع المجال لذكرها، ومنها ـ لا على سبيل الحصر ـ: «حربُ عليِّ حربي، وسلمُ عليِّ سلمي»، و«مَن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه وانصر مَن نصره واخذل مَن خذله» إلى غير ذلك.
[601] القصيدة للسيد جعفر الحلي&، وقد تقدّمت ترجمته في المحاضرة الخامسة، فراجع.
[602] المائدة: آية55.
[603] تفسير الأمثل: ج4، ص45 ـ 46، ذكره عن مجمع البيان: ج2، ص210، في ذيل الآية المبحوثة.
[604] كشف الغُمّة: ج1، ص307. شواهد التنـزيل: ج1، ص235 ـ 236.
[605] اُنظر: تفسير الأمثل: ج4، ص49.
[606] المستشكل هو الفخر الرازي في تفسيره: ج12، ص30 ـ 31، وغيره.
[607] تفسير الأمثل: ج4، ص51.
[608] المصدر نفسه: ج4، ص51.
[609] وفيات الأئمّة: ص60 ـ 61.
[610] نسبه شيخنا الأستاذ الشيخ مُحمّد سعيد المنصوري& لبعض الشعراء ولم يذكره، ولم أعثر عليه رغم البحث الطويل فلِلّه درّه وعلى اللهِ أجره.
[611] الأحزاب: آية33.
[612] اُنظر: الأخلاق والآداب الإسلامية: ص543.
[613]اُنظر: عين الحياة: ج1، ص166.
[614] تفسير الأمثل: ج13، 237.
[615] تفسير الأمثل: ج13، ص244.
[616] اُنظر: بحار الأنوار: ج42، ص290 ـ ص291.
[[617]) من دروس شيخنا الأستاذ الأديب مُحمّد سعيد المنصوري&.
[618] القصيدة للشاعر الشيخ مُحمّد حسن سميسم&، قال عنه في أدب الطف: ج9، ص91 ـ 94ـ:«أسرة آل سميسم، اشتهرت بهذا اللقب؛ لأنَّ جدها سميسم بن خميس بن نصار بن حافظ لهم الزعامة في بني لام بن مفرج بن سلطان بن نصير أمير بني لام، حيث نـزح من الشام حدودسنة 902 هـ وأسس مشيخة بني لام في لواء العمارة (ميسان) فأعقب حافظ وهو أعقب ولدين: نصار ونصر وفيهما زعامة بني لام. وفي أسرة آل سميسم ـ اليوم ـ علماء وأدباء وحقوقيون. وكان المترجم له علم الأسرة وعنوانها؛ لِمَا يتحلّى به من فضل وأدب وسخاء، مضافاً إلى ديانته وزهادته، وطيب سريرته وحسن سيرته، يتحلّى بإباء وشمم، ويعتزّ بقوميته وعروبته لا عن عصبية... ولد سنة 1279 هـ، كما ترجم له الخاقاني في شعراء الغري، وذكر جملة من نثره ونظمه. وافاه الأجل في 25 جمادى الأُولى سنة 1343 هـ، وكان لنعيه رنّة أسف على عارفيه،وأبّنه جماعة من الشعراء منهم الخطيب الشيخ محمد علي اليعقوبي بقصيدة عامرة كان مطلعها:
أيَعرب قــد فـقدتِ أبا الجواد فلا للجود أنت ولا الجياد
وللمترجم له قصيدة في الزهراء فاطمة بنتِ النبي صلى الله عليهما وسلّم جاء في أولها:
مَن مبلغ عني الزمان عتابا ومــقــرّعٌ مـــنّي لـــــه أبوابا
لا زلت أُرددها في المحافل الفاطمية. تغمده الله برحماته وأسكنه فسيح جناته».
[619] من وصية النبيّ’ لأبي ذرّ&، راجع عين الحياة: ج1، ص218.
[620] مكارم الأخلاق: ص458 ـ 471.
[621] تنبيه الخواطر: ج2، ص51 ـ 68.
[622] اُنظر: بحار الأنوار: ج74، ص73 ـ 91، ح3.
[623] اسم هذا الشرح: عين الحياة طبعة جماعة المدرّسين بقم المقدّسة.
[624] اُنظر: تفسير الأمثل: ج6، ص541، مع تصرّف في العبارة.
[625] تفسير الأمثل: ج6، ص529.
[626] هود: آية38.
[627] هود: آية42.
[628] هود: آية42.
[629] هود: آية43.
[630] هود: آية46.
[631] البقرة: آية58.
[632] تفسير البرهان: ج1، ص229.
[633] أمالي الشيخ الصدوق: ص707، ح4. كنـز الفوائد: ص197. بحار الأنوار: ج23، ص99، ح1، عن الأمالي. عين الحياة: ج1، ص118.
[634] تفسير العيّاشي: ج1، ص45، ح47. تفسير جوامع الجامع: ج1، ص108. تفسير مجمع البيان: ج1، ص229. تفسير نور الثقلين: ج1، ص83، ح213. تفسير البرهان: ج1، ص230. تفسير كنـز الدقائق: ج1، ص254. بحار الأنوار: ج13، ص168، وج23، ص122، ح26، عن تفسير العيّاشي.
[635] كتاب سليم بن قيس: ص150. بحار الأنوار: ج28، ص269.
[636] الأنوار القدسيّة: ص42.
[637] المقصود هنا جبرائيل×.
[638] القصيدة للشاعر محسن الحويزي الحائري المعروف بـ(أبوالحَب)&، قال عنه في أدب الطفّ ـ ج8، ص56 ـ 57 ـ: «الشيخ محسن خطيب بارع وشاعر واسع الآفاق خصب الخيال، ولد سنة 1235 هـ ونشأ بعناية أبيه وتربيته، وتحدّر من أُسرة عربية تُعرف بآل أبي الحَب، وتمتُّ بنسبها إلى قبيلة خثعم، وتدّرج على نظم الشعر ومحافل الأدب وندوات العلم، ولا سيما ومجالس أبي الشهداء مدارس سيارة، وهي من أقوى الوسائل لنشر الأدب وقرض الشعر، فلقد جاء في يوم الحسين× من الشعر والخطب ما يتعذّر على الأدباء والمعنيين بالأدب جمعه أوالإحاطة به، وشاعرنا الشيخ محسن نظم فأجاد، وأكثر من النوح والبكاء على سيد الشهداء×، وصوّر بطولة شهداء الطف تصويراً شعرياً لا زالت الأُدباء ومجالس العلماء تترشفه وتستعيده وتتذوقه...توفي ليلة الإثنين 20 ذي القعدة عام 1305 هـ، ودفن في الروضة الحسينية المقدّسة إلى جوار مرقد السيد إبراهيم المجاب».
[639] آل عمران: آية33 ـ 34.
[640] تفسير الميزان: ج3، ص164.
[641] تفسير الأمثل: ج2، ص471 ـ 472.
[642] تفسير الأمثل: ج2، ص473 ـ 474.
[643] البقرة: آية30.
[644] طه: آية122.
[645] طه: آية123.
[646]الصافات: آية77 ـ 79.
[647] اُنظر: تفسير الميزان: ج3، ص167 ـ 168.
[648] اُنظر: تفسير كنـز الدقائق: ج2، ص67.
[649] الخصال: ص206 ـ 207، ح25. مكارم الأخلاق: ص444. تفسير نور الثقلين: ج1، ص229، ح101. ينابيع المودّة: ج2، ص274، ح783. بحار الأنوار: ج43، ص99، ضمن حديث11.
[650] مجمع مصائب أهل البيت^: ج4، ص62.
[651] القصيدة للسيّد عبّاس البغدادي&، قال عنه السيد جواد شبّر في أدب الطف: ج8، ص242 ـ 246: «السيد عبّاس الموسوي البغدادي، ابن علي بن حُسين درويش... ابن إبراهيم المُجاب بن محمد العابد بن الإمام موسى الكاظم×... كان من خُطباء بغداد البارزين بل خطيبها الأوّل، اشتُهر بالفضل والصّلاح. وُلد سنة إحدى وسبعين ومائتين بعد الألف هجرية (1271هـ) بمدينة بغداد ونشأ فيها، درس النحو والمنطق، وقد سجّل المُترجم له مبدأ تدرّجه على الخطابة في كتابه (المآتم لمَن رام التعزية) فقال: كنتُ في عنفوان الشباب شديد الاشتياق إلى استماع المراثي الحسينيّة، وأتطّلب المجالس التي تُعد لمصابه، فزوّجني أبي من ابنة معلّمي، وذلك سنة (1287هـ) وبقيت معه ألتقط من نائلِه ست سنوات، ثمَّ مضى بعدها للحلّة وفيها قومه وعشيرتُه، وهُم يُعدّون من أشرافها، فمكث فيها ستّة أشهر، وتُوفي فيها سنة ألف ومائتين وثلاث وتسعين (1293هـ)، تغمّده الله برحمته... له قصيدة في المجالس الحسينيّة ومنها:
فيا راكباً مُهرية شأت الصبا كأنَّ لها خيـط الخـيال زمـامُ
... لقد قضى السيّد عبّاس عُمراً في خدمة المنبر الحسيني واعظاً ومُرشداً ومُحدّثاً وناصحاً، ومنابر بغداد تشهد له، ومحافلها تذكره بكلِّ إعزاز وفخر».
[652] إبراهيم: آية7.
[653] مفردات ألفاظ القرآن: ص265.
[654] الكافي: ج2، ص96، ح15، عنه بحار الأنوار: ج68، ص32، ح10.
[655] نهج البلاغة: ج4، ص102، رقم435، عنه بحار الأنوار: ج6، ص36، ح58، وج68، ص24، وص54، وج90، ص366، ح15.
[656] الاحتجاج: ج1، ص326. واُنظر: حلية الأبرار: ج1، ص245. التفسير الصافي: ج3، ص299. تفسير نور الثقلين: ج3، ص367، ح10، وج4، ص317. بحار الأنوار: ج17، ص287. و ج68، ص26. والجميع ما عدا الحلية عن كتاب الاحتجاج.
[657] الكافي: ج2، ص97، ح18، عنه تفسير نور الثقلين: ج5، ص397، ح59. بحار الأنوار: ج68، ص32، ح12، عن الكافي.
[658] أمالي الشيخ الطوسي: ص450. وسائل الشيعة: ج16، ص312، ح12. بحار الأنوار: ج7، ص223 ـ ص224، ح141، عن الأمالي، وج66، ص70.
[659] مثل قوله تعالى: (سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) البقرة: آية211. وآيات أُخر كثيرة بهذا المضمون.
[660] الكافي: ج2، ص96، ح14، عنه التفسير الصافي: ج1، ص83. تفسير نور الثقلين: ج1، ص15، ح58، وج2، ص529، ح22. بحار الأنوار: ج68، ص32، ح9، عن الكافي.
[661] إبراهيم: آية34.
[662] أمالي الشيخ الصدوق: ص527 ـ 528، ح6. عيون أخبار الرضا: ج1، ص57، ح203، عنه بحار الأنوار: ج22، ص320، ح8، وج68، ص45، ح51.
[663] الكافي: ج2، ص98، ح27. قصص الأنبياء (الراوندي): ص164، ح178. قصص الأنبياء (الجزائري): ص346. رياض السالكين: ج1، ص314، وج5، ص233. بحار الأنوار: ج13، ص351، ح41، وج68، ص36، ح22، عن الكافي.
[664] الصحيفة السجادّية: ص184 (دعاؤه في الشكر). المصباح (الكفعمي): ص413.
[665] الصحيفة السجادية (أبطحي): ص410 (مناجاة الشاكرين). بحار الأنوار: ج91، ص146.
[666] إشارة إلى آية التطهير حيث يقول عزّ من قائل: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) الأحزاب: آية33، واُنظر: مقدمة كتاب كلمة فاطمة الزهراء‘ للسيد حسن الشيرازي&.
[667] اُنظر: خطبة الزهراء‘ في المصادر التالية:
الاحتجاج: ج1، ص145. مناقب آل أبي طالب: ج2، ص50. الدر النظيم: ص478. بحار الأنوار: ج29، ص234. شرح الأخبار: ج3، ص34 ـ 40. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص264. بلاغات النساء: ص13 ـ 20. الشافي في الإمامة: ج4، ص71. وهناك الكثير من المصادر قد ذكرتها.
[668] اُنظر: بحار الأنوار: ج43، ص177.
[669] مجمع مصائب أهل البيت^: ج4، ص69.
[670] القصيدة للشاعر الشيخ محمد حسن المُراياتي الكاظمي&، ولم أعثر على ترجمته.
[671] الإسراء: آية26.
[672] الكافي: ج1، ص543، ح5. فقه القرآن (الراوندي): ج1، ص248. التفسير الصافي: ج3، ص186، عن الكافي. تفسير نور الثقلين: ج3، ص154، ح158. غاية المرام: ج3، ص384، ح1. بحار الأنوار: ج48، ص156 ـ 157، ح29، عن الكافي.
[673] تفسير البرهان: ج4، ص551 ـ 555.
[674] اُنظر: تفسير الدرّ المنثور: ج4، ص177.
[675] اُنظر: شواهد التنـزيل: ج1، ص438 ـ 441، حديث (468، 469، 471، 472، 473).
[676] اُنظر: كنـز العُمّال: ج3، ص767، ح8696.
[677] اُنظر: ينابيع المودّة: ج1، ص138، ص359، ح18 وح19.
[678] التعجب: ص129، وقد كتب الشيخ المفيد& رسالة في هذا الحديث وافية، فمَن أحبَّ مراجعتها فليراجعها، ففيها الكفاية لمَن له أدنى دراية؛ ليدرك أنَّ الحديث من موضوعات السلطة لمنع الزهراء‘ من فدك، ولم يعرفه ولم يسمعه ولم يروه حتى ذلك اليوم غير أبي بكر.
[679] شرح نهج البلاغة: ج16، ص211.
[680] النمل: آية16.
[681] مريم: آية5 ـ 6، واُنظر: مصادر الخطبة فيما تقدّم.
[682] اُنظر: خطبة الزهراء‘ في المصادر التالية: الاحتجاج: ج1، ص145. مناقب آل أبي طالب: ج2، ص50. الدر النظيم: ص478. بحار الأنوار: ج29، ص234. شرح الأخبار: ج3، ص34 ـ 40. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص264. بلاغات النساء: ص13 ـ 20. الشافي في الإمامة: ج4، ص71. وغيرها.
[683] الأحزاب: آية33.
[684] الاحتجاج: ج1، ص122 ـ 123. تفسير القُمي: ج2، ص155 ـ 157. تفسير نور الثقلين: ج4، ص186 ـ 187، ح71. غاية المرام: ج5، ص348 ـ 349. بحار الأنوار: ج29، ص128ـ 130، عن الاحتجاج.
[685] اُنظر هذين الحديثين في المصادر التالية: المستدرك على الصحيحين: ج3، ص126 ـ 127. المعجم الكبير: ج11، ص55. الاستيعاب: ج3، ص1102. الفايق في غريب الحديث: ج2، ص16. شرح نهج البلاغة: ج7، ص219. الجامع الصغير: ج1، ص415، ح2705. تحفة الأحوذي: ج10، ص155، والحديث مستفيض عندنا.
[686] المسائل الصاغانية: ص109. الخصال: ص551. عيون أخبار الرضا: ج2، ص80. الإيضاح: ص230. شرح الأخبار: ج2، ص333. الفصول المختارة: ص135. الاحتجاج: ج1، ص175. شرح نهج البلاغة: ج1، ص18، وقال: «وقد روت العامّة والخاصّة قوله’ أقضاكم علي» ومثله في إشارة السبق: ص54. دعائم الإسلام: ج1، ص92. المواقف: ج3، ص627. كشف الخفاء: ج1، ص162، ح489. الانصاف فيما تضمنه الكشّاف: ج2، ص272. أحكام القرآن: ج4، ص43. تفسير القرطبي: ج15، ص162. الوافي بالوفيات: ج21، ص179، وغيره الكثير.
[687] اُنظر: السيرة الحلبية: ج3، ص488
[688] اُنظر: شرح نهج البلاغة: ج16، ص234 ـ 235 «إلا أنّه ناقش في ثبوت القضيّة» فراجع كلامه ترى ما فيه من استبعادٍ محض بلا دليل ولا حُجّة.
[689] اُنظر: معجم البُلدان: ج4، ص238 ـ 240.
[690] شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ج16، ص215.
[691] شرح نهج البلاغة: ج16، ص214 ـ 215، عنه بحار الأنوار: ج29، ص325 ـ 326، ح10. سفينة النجاة: ج1، ص344.
[692] صحيح البخاري: ج4، ص210. فضائل الصحابة: ص78.
[693] من قصيدة رائعة للحيص بيص ولها قصة ظريفة، اُنظر: الوافي بالوفيات: ج15، ص104. الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص842، وجاء في ترجمته في هامش المصدر المذكور أنّه: أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن صيفي التميمي، المتوفي في بغداد سنة (574هـ) ففيه شافعي جدلي غلب عليه الشعر فشُهر به. ولُقِّب بالحيص بيص لأنّه رأى قوماً في اضطرابٍ من شيءٍ بلغهم فقال: ما بال القوم في حيص بيص، أي في شدّة وضيق.
[694] بناء المقالة الفاطمية: ص180. واُنظر: المعجم الكبير: ج5، ص184. نظم درر السمطين: ص332. الاصابة: ج8، ص266. تاريخ مدينة دمشق: ج13، ص218. (والمصادر ما عدا الأول فيها تقديم وتأخير)
[695] اُنظر: بحار الأنوار: ج39، ص332. تفسير البرهان: ج6، ص314، ح6. نهج الأعيان: ص62. الفصول المختارة: ص88. التعجّب: ص135. الملاحم والفتن: ص243.
[696] أمالي الشيخ الصدوق: ص157، ح2. عيون أخبار الرضا: ج1، ص72، ح308. المستدرك على الصحيحين: ج3، ص121. الجامع الصغير: ج2، ص608، ح8736. كنـز العُمال: ج11، ص573. المناقب: ص137، وغيره الكثير.
[697] هذه الأبيات من قصيدة رائعة للمرحوم السيد علي التُرك. اُنظر: مجمع مصائب أهل البيت^: ج4، ص72.
[698] القصيدة لأُستاذنا الأديب الشيخ مُحمّد سعيد المنصوري&، وقد تقدَّمت ترجمته في المحاضرة الرابعة من هذا الكتاب فراجع.
[699]أمالي الشيخ المفيد: ص323. الاحتجاج: ج2، ص31، عنه بحار الأنوار: ج45، ص164.
[700]كنـز الفوائد: ص129، نسبه إلى ابن وكيع الشاعر مع تغيير يسير في البيت، وفي كتاب المراجعات: ص314، نسبه إلى المتـنبي، والثاني أظهر.
[701] التحصيل في أيام التعطيل: ص244.
[702]مقتل الإمام الحسين×(أبو مخنف): ص165 ـ 167. مقاتل الطالبيين: ص60.
[703] وفيات الأئمّة: ص431.
[704] وفيات الأئمّة: ص436.
[705] اُنظر: المصدر نفسه.
[706] اُنظر: السنن الكبرى: ج5، ص392. الأدب المفرد: ص202.
[707] بحار الأنوار: ج45، ص138.
[708] اُنظر: عيون أخبار الرضا×: ج1، ص74، ح321.
[709] شجرة طوبى: ج2، ص392.
[710] المصدر نفسه.
[711] اُنظر: العقيلة زينب والفواطم: ص3 ـ 30.
[712] اُنظر: سياسة الحسين×: ج2، ص106 ـ 115.
[713] موسى بن خزرج الأشعري، هو كبير قومه في قمّ حينذاك.
[714] القصيدة لأستاذنا الخطيب الشيخ محمد سعيد المنصوري&، وقد تقدَّمت ترجمته في المحاضرة الرابعة.
[715] بحار الأنوار: ج57، ص216 ـ ص217، ح41. سفينة البحار: ج7، ص358 ـ 359.
[716] منتهی الآمال: ج2، ص378.
[717] كامل الزيارات: ص563، باب106، ح201.
[718] نظرة إلى حياة السيدة فاطمة المعصومة‘: ص7.
[719] الكافي: ج1، ص477، ح2. مناقب آل أبي طالب: ج1، ص228. بحار الأنوار: ج48، ص6، ح7، عن الكافي.
[720] نظرة إلى حياة السيدة فاطمة المعصومة‘: ص9.
[721] وذلك في سنة 200 للهجرة.
[722] والفرسخ بمقدار (5,5) كيلو متراً تقريباً عند الفقهاء(قُدس سرهم).
[723] نظرة إلى حياة السيدة فاطمة المعصومة‘: ص25.
[724] شجرة طوبی: ج1، ص23، (مع اختلاف يسير). ومجمع مصائب أهل البيت^: ج3، ص267.
[725] اعتقل السيد& في الإنتفاضة الشعبانية سنة 1991م، وقيل إنّه استشهد بعد فترة وجيزة.