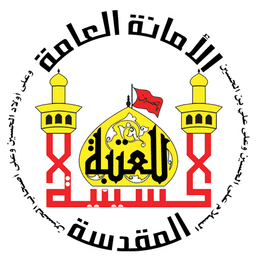مقدّمة المؤسّسة
من هنا؛ قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإنشاء المؤسّسات والمراكز العلمية والتحقيقية؛ لإثراء الواقع بالمعلومة النقية؛ لتنشئة مجتمعٍ واعٍ متحضّر، يسير وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.
وممّا لا شكّ فيه أنّ القضية الحسينية ـ والنهضة المباركة القدسية ـ تتصدّر أولويات البحث العلمي، وضرورة التنقيب والتتبّع في الجزئيات المتنوّعة والمتعدّدة، والتي تحتاج إلى الدراسة بشكلٍ تخصّصـي علمي، ووفق أساليب متنوّعة ودقيقة، ولأجل هذه الأهداف والغايات تأسّست مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، وهي مؤسّسة علميّة متخصّصة في دراسة النهضة الحسينية من جميع أبعادها: التاريخية، والفقهية، والعقائدية، والسياسية، والاجتماعية، والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة المرتبطة بهذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكفّل بدراسة سائر ما يرتبط بالإمام الحسين×.
وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق هذه المؤسّسة المباركة؛ كونها مختصّة بأحد أهمّ القضايا الدينية، بل والإنسانية، فقد قامت بالعمل على مجموعة من المشاريع العلمية التخصّصية، التي من شأنها أن تُعطي نقلة نوعية للتراث، والفكر، والثقافة الحسينية، ومن تلك المشاريع:
1ـ قسم التأليف والتحقيق: والعمل فيه جارٍ على مستويين:
أ ـ التأليف، والعمل فيه قائم على تأليف كتبٍ حول الموضوعات الحسينية المهمّة ، التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما ويتمّ استقبال الكتب الحسينية المؤلَّفة خارج المؤسّسة، ومتابعتها علميّاً وفنّياً من قبل اللجنة العلمية، وبعد إجراء التعديلات والإصلاحات اللازمة يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق، والعمل فيه جارٍ على جمع وتحقيق التراث المكتوب عن الإمام الحسين× ونهضته المباركة، سواء المقاتل منها، أو التاريخ، أو السيرة، أو غيرها، وسواء التي كانت بكتابٍ مستقل أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (الموسوعة الحسينيّة التحقيقيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على متابعة المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ لجمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتم استقبال الكتب التي تم تحقيقها خارج المؤسسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها وإدخال التعديلات اللزمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في المؤسسة.
2ـ مجلّة الإصلاح الحسيني: وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية، والفقهية، والأدبية، في تلك النهضة المباركة.
3ـ قسم ردّ الشبهات عن النهضة الحسينية: ويتمّ فيه جمع الشبهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، ثمّ فرزها وتبويبها، ثمّ الرد عليها بشكل علمي تحقيقي.
4 ـ الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×: وهي موسوعة تجمع كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية، ووضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام× والواقع العلمي.
5 ـ قسم دائرة معارف الإمام الحسين×: وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالنهضة الحسينية من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء أعلام وأماكن، وكتب، وغير ذلك من الأُمور، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، ومكتوبةٌ بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ سلس.
6 ـ قسم الرسائل الجامعية: والعمل فيه جارٍ على إحصاء الرسائل الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، كما ويتمّ إعداد موضوعات حسينيّة تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.
7 ـ قسم الترجمة: والعمل فيه جارٍ على ترجمة التراث الحسيني باللغات الأُخرى إلى اللغة العربيّة.
8 ـ قسم الرصد: ويتمّ فيه رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في الفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية بمختلف المعلومات.
9 ـ قسم الندوات: ويتمّ من خلاله إقامة ندوات علميّة تخصّصية في النهضة الحسينية، يحضـرها الباحثون، والمحقّقون، وذوو الاختصاص.
10 ـ قسم المكتبة الحسينية التخصصية: حيث قامت المؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المطبوع.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها قريباً إن شاء الله تعالى.
وتأسيساً على ما سبق توضيحه حرصت المؤسّسة على فتح أبوابها لاستقبال الكتب الحسينية التخصّصيّة، ومتابعتها متابعة علميّة وفنّية من قبل اللجنة العلمية المشـرفة في المؤسّسة، وفي هذا السياق قدَّم فضيلة الحجّة السيد حسين وتوت عملاً تحقيقيّاً رصيناً يُشكر عليه، حيث قام بتحقيق رسالة (عدد المخرجين لحرب الإمام الحسين×) للعلامة آية الله السيد حسن الصدر&، وقد أضاف لها السيد المحقّق بعض الفصول؛ لتتمّ بها الفائدة ويكتمل النفع؛ فكانت حصيلة ذلك الجهد المبارك هذا الكتاب القيّم الماثل بين يديك عزيزي القارئ.
وفي الختام نتمنّى لفضيلة السيّد المحقّق دوام السداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، إنّه سميعٌ مجيبٌ.
تكرّم علينا أعلامٌ نبلاء، وأساتذةٌ أجلاء، وكرامٌ فضلاء، في تقريض تحقيق هذه الرسالة. ونحن إذ نثمّن لهم قراءة هذا التحقيق وتقييمه، نُصدّر كتابنا هذا بما قدّموه؛ اعتزازاً وتقديراً واحتراماً. وإن كانت كلماتهم موجزة ومختصرة، إلّا أنَّها تُنزل تحقيق هذه الرسالة ما يستحقه من منزلة، فهي: (كافيةٌ شافية، ومجزيةٌ مُغنية، بل لوجدناها فاضلةً على الكفاية، وغير مُقصّـرة عن الغاية، وأحسنُ الكلام ما كان قليله يُغنيك عن كثيرة).
وهم:
ـ سماحة آية الله السيّد محمد مهدي الموسوي الخرسان (حفظه الله).
ـ العالم والمؤرّخ الأُستاذ الدكتور السيّد حسن الحكيم المحترم.
ـ العالم الأديب والمُحقق الماهر السيّد عبد الستار الحسني المحترم.
حفظهم الله تعالى ذخراً للعلم والفضيلة.
كلمة سماحة آية الله السيّد محمد مهدي الخرسان (حفظه الله)
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)[1].
باسمه تعالى شأنه.
بارك الله في عملِك، وبلّغك أقـصى أملك، وجعلك خير خلفٍ لخيرِ سلفٍ إنْ شاء الله.
ففي الحديث الشـريف: «إذا مات الإنسان انقطع عملُه إلّا من ثلاثة: إلّا من صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له»[2].
جعلك الله مقبول العمل، مُوفقاً في هذا المسلك الذي أحييت به أباك وأهلك، وبلّغك أمانيك في عمل الصالحات لخدمة الدين وأهله[3].
بدعاء محمد مهدي الموسوي الخرسان
ليلة الأربعاء14/ج1/سنة1434هـ
كلمة الأُستاذ الدكتور السيّد حسن الحكيم
سماحة العلّامة السيّد حسين وتوت المحترم.
تحية طيبة.
تحقيقكم لكتاب (رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين× في الطفّ) جيدٌ ورائعٌ، قد استوفى أُصول البحث العلمي والتحقيق الدقيق.
والرسالة المذكورة تقع بين (119 ـ 137) صفحة[4]، أي: في ثماني عشـرة صفحة، وهذا يستدعي تغيير عنوان الكتاب؛ طالما أنَّ دراسة المؤلف، ومنهج التحقيق قد استوعب القسم الأكبر من الكتاب، فأرى العنوان المناسب للمحتوى العام:
السيّد حسن الصدر في رسالته: (عدد المُخرَجين لحرب الحسين في الطفّ) دراسة وتحقيق.
فإنَّ العنوان المُقترح يشمل المؤلِّف والكتاب على قصره ومحدودية مادته[5].
وكنت قد وقفت على ثقافتكم العالية في التحقيق، والرجوع إلى المصادر والمراجع لتحقيق النصوص، والتأكد من سلامتها، وهذه مهمّة المُحقق المتتبّع.
وفّقكم الله تعالى لنتاجات علميّة في المستقبل، ومنه تعالى نستمدُّ التوفيق.
الأُستاذ الدكتور حسن الحكيم
1434هـ/2013م
كلمة المؤرخ والأديب المُحقق السيّد عبد الستار الحسني
باسمه تعالى.
سماحة العلّامة المُحقق الحجة الثبت الأُستاذ السيّد حسين آل وتوت الحسني (دام كما رام)،
بعد السلام مشفوعاً بخالص الدعاء.
اطّلعتُ على تحقيقكم لـ (رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين× في الطفّ) فراقني، وظهر لي من خلال الجوْس في خلاله[6]، أنَّ سماحتكم قد وهبكم الله تعالى ملكة هذا الفنِّ، فامتلكتم ناصيته[7].
وقد أوْفيتُم على الغاية فيما عَلَّقْتُم به من (بدائع الفوائد) على الرسالة المذكورة، فجاءت تميسُ[8] بحُللٍ قشيبة[9]، لو شامها[10] (الماتنُ)[11] لقال هذا هو الحقيق بتحقيقها.
وإذا كان تحقيقك لهذه الرسالة هو باكورة أعمالك في هذا المجال، فما الظنُّ بما ستُرْدفُونَهُ من سائر التحقيقات في قابل الأيام.
عبد الستار الحسني
لقد حضـرت دورة في تعلّم فنّ تحقيق المخطوطات من قِبل مؤسسة المرتضـى في مدينة النجف الأشرف، وكان من متطلبات النجاح في هذه الدورة، هو أن يُحقِّق كلُّ مَن حضر مخطوطةً صغيرة الحجم.
ومن منطلق الحديث: «مَن لم يشكرِ المُنعم من المخلوقين لم يشكر الله»[12]، يجب عليّ ـ بعد أن وفّق الله سُبحانه وتعالى في إعداد هذا التحقيق المتواضع لهذه الرسالة القيمة ـ أن أتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى سماحة العلّامة المُحقق السيّد محمد رضا الجلالي (حفظه الله) لأُمور، منها:
أوّلاً: لمِا بذله من جهد من خلال المحاضرات التي ألقاها على المشتركين في تلك الدورة، وإعداده طليعة واعية من المُحققين؛ ليكونوا من العاملين في إحياء التراث، والمساهمين في تحقيقه ونشـره بمنهج علمي رصين، وأمانة وصدق وإخلاص.
ثانياً: لمراجعته تحقيق المخطوطات التي قُدّمت لمَن حضـر في هذه الدورة.
وأمّا عن كتابنا هذا، فقد بذل سماحة السيّد العلّامة المُحقّق (حفظه الله) جهداً كبيراً في مراجعته؛ من أجل الاطّلاع على تحقيق المخطوطة، وتسجيل الملاحظات القيّمة، ومنها ما أثبته في تقويم نصّ الكتاب.
ونُذكّر أيضاً أنَّ هذه النُّسخة المراجعة من قِبل السيّد المُحقق، قد طرأت عليها إضافات، منها: التقاريض، وكلمات الشكر والثناء.
وكذلك لا أنسى أن أُقدّم شكري إلى القائمين على مؤسسة المرتضـى، على ما يبذلون من جهد في إعداد هذه الدورات العلميّة والتعليميّة، وتنظيمها، لا سيّما المُعَدّة لطلبة الحوزة العلميّة.
وأخيراً أتقدّم بخالص شكري وامتناني لمؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية في النجف الأشرف، وإدارتها وكادرها؛ لما بذلوه من جهود في تحقيق وتقويم هذا الجهد.
أُهدي عملي هذا ـ وعسى أن يكون فيه ما يستحق الإهداء ـ إلى سيّد الكونين والثقلين والفريقين، الذي حمل بين أضلاعه أقدس قلب، وعلى مُحيّاه أعزّ عين، وفي مشاعره أكرم دمعة، ذلك هو الرسول الأعظم محمد|، الذي بكى سبطه الإمام الحسين، ونعاه ورثاه في مواضع كثيرة.
وإلى تلك العيون التي اغرورقت بالدموع؛ لقتل سيّد الشهداء×، فإنَّها ما زالت تبكيه ما طلعت شمس وما غربت.
وإلى كلّ الذين اعتقدوا الحسين عقيدةً في نهج الشـريعة، وإصلاحاً في المنهج والسلوك، ولواءً في سوح الوغى، وعزّةً وإباءً
بوجه الظلم والظالمين، وعزّةً وكرامةً في ميادين الحياة.
مقدّمة التحقيق
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته، وأصحابه المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.
أمَّا بعدُ، فقد كنت مُحباً للاطّلاع على عالم المخطوطات وتحقيقها، شغوفاً في معرفة مناهج المُحققين وأساليبهم، متابعاً لمِا يصدر عنهم، وما من شيء يتعلّق بهذا الأمر إلّا وكنت من رواده ومن السبّاقين إليه، لاسيّما الدورات التي تُعقد في تعلم فنّ التحقيق، أو الندوات التي تُخصّص للبحث في هذا العنوان.
ولقد كنت من المحظوظين في حضور الدورة المُشار إليها فيما تقدّم، وفي ختامها حصلت على مخطوطة من خلال مؤسسة المرتضـى في النجف الأشرف؛ من أجل تحقيقها وتطبيق ما اطلعت عليه من فنّ التحقيق.
وقد اختلف المعاصرون في منهج التحقيق عند المُحدّثين إلى نوعين، تجدر الإشارة لهما في هذه الفقرة:
«غاية التحقيق هو تقديم المخطوط صحيحاً كما وضعه مؤلفه، دون شرحه.
إنَّ الكثيرين من الناشرين لا ينتبهون إلى هذا الأمر، فتجد الحواشي مَلْأى بالشـروح والزيادات: من شرح للألفاظ، وترجمات للأعلام، ونقل من كتب مطبوعة، وتعليق على ما قاله المؤلف، كلّ ذلك بصورة واسعة مُملّة، قد تشغل القارئ عن النصّ نفسه، ولم توجد في المخطوطة»[13].
وهذه الفقرة تحدد ملامح الاتجاهين في التحقيق:
الأوّل: يجب أن يكون كما وضعه مؤلفه، دون شرحه.
الثاني: أن تُملأ فيه الصفحات بـشرح للألفاظ، وترجمات للأعلام، ونقل من كتب مطبوعة، وتعليق على ما قاله المؤلف.
وهنا يمكن أن نُحدد منهجاً لا يتعارض مع المنهجين، وهو أن نُفرّق بين المصطلحات وتطبيقها، بأن يُضاف إلى مصطلح (التحقيق) مصطلح آخر: (التحرير)، وهو مما تعارف عليه القدماء[14].
وعلى ضوء هذين المصطلحين يمكن تحديد المنهج الذي يجب أن يُتّبع مع المخطوطة.
فقد يوجد مخطوط لا يستحق إلّا تطبيق المنهج الأوّل عليه، وهو (كما وضعه مؤلفه، دون شرحه)، وهذا نُعبّر عنه بـ (تحرير النصّ)، أو (تحرير المخطوط). وهناك مخطوط من حقّه التحقيق، وهو العمل الذي يشمل (التحرير، وشرح للألفاظ، وترجمات للأعلام، ونقل من كُتب مطبوعة، وتعليق على ما قاله المؤلف)، وغيرها من المسائل المتعارف عليها؛ لأنَّه قد يوجد مخطوط قد تُسـيء له ولمؤلفه إن اقتصـرت على تحريره؛ إذ من حقّه أن يُتّبع فيه منهج (التحقيق)، وكذلك فيما يُتّبع فيه المنهج الثاني ومن حقّه (التحرير).
ومن هنا لا يمكن أن نضع قاعدةً عامّةً ومنهجاً واحداً لجميع المخطوطات، فالمخطوطة يجب أن يُحدد لها منهج، فإمّا (تحرير) وإمّا (تحقيق).
وكذلك لا يمكن تحديد النسبة بين (الُمحرر) و(المُحقق)، فقد تكون العموم، وقد تكون الخصوص من وجه.
ونحن هنا اتبعنا المنهج الثاني في عملنا هذا؛ لأنَّ هذه المخطوطة من حقّها (التحقيق) وليس (التحرير).
وهي رسالة من مُصنّفات العالم الجليل والمؤلف الكبير السيّد حسن الصدر+. وموضوعها: هو تعيين عدد الذين أُخرجوا لحرب الإمام الحسين× في الطفّ من الجيش الأُموي.
وهي جواب لسؤال ورد إليه من السيّد عبد الحسين الكليدار، خازن الروضة الحسينيّة.
ومن ضروريات التحقيق ـ حين ابتدأت العمل في تحقيقها ـ وجوب البحث عن نُسخة المؤلف التي كتبها بيده (المُسوَّدة) أو (المُبيَّضة) إن كُتبت لها، أو نُسخة من إملائه، أو مكتوبة عن نُسخته، أو قريبة من عصره، أو غيرها من النُّسخ إن وجدت، وأنظر فيما إذا حُققت من قبلُ، وأجمع كلّ ما ورد عنها وقيل فيها.
وفي أثناء البحث والسؤال والمتابعة أخبرني الأخ العزيز أحمد الحلي عن المخطوطة بأنَّها مُحقّقة، ونُسخة منها في مكتبة الإمام الصادق× في النجف الأشرف.
وحين اطّلاعي عليها عرفت أنَّها حُقّقت على يد المُحقق الأُستاذ منتظر الحيدري في 13/جمادى الآخرة/1433هـ، وطُبعت في السنة نفسها، ونشـرها (مركز جنّة الحسين× للدراسات الإسلاميّة، في كربلاء).
وقد ذكر المُحقّق مقدّمةً عن تحقيقه لهذه المخطوطة، وكيفية حصوله على نُسخها المخطوطة، فقال: «في أوائل العام (1432هـ) وقفتُ على أسماء مُصنّفات السيّد حسن الصدر+ في كتاب (مُعجم مؤلفي الكاظمية)، للدكتور الفاضل الشيخ محمد المنصور، ومن بين تلك المُصنّفات ذكر كتاب (عدّة مَن خرج إلى حرب الحسين×، وأنَّهم ثلاثون ألفاً على الأقل)، فعلُق العنوان بقلبي حتى جاء اليوم الذي وفقني الله سُبحانه فيه، إذ أهداني المُحقق الجليل والأُستاذ النبيل الحاج جعفر البيّاتي نُسخةً من قرص ليزري يحتوي على الكثير من صور مخطوطات السيّد المُصنف+، فأخذت أبحث عن النُّسخة المنشودة حتى وقفت على نُسختين لهذا المُصنف+، فحمدتُ الله سُبحانه وأخذت في تحقيقه ونشره؛ ابتغاءً لمرضاة الله سُبحانه، وإظهاراً، بل إخباراً بما جرى على الحسين× وسائر أهل بيت الرسالة^، في العاشر من محرّم الحرام سنة (61هـ).
بل وتأديةً لحقوق مُصنف هذا السفر العظيم، والصـرح القويم، العالم العامل، وحيد عصـره، وسيّد دهره، زعيم الخاصّ والعامّ، المرجع الديني الكبير السيّد حسن الصدر+...». انتهى كلام المُحقق.
ومن خلال قراءتي بإمعان ونظر في هذه النُّسخة المُحققة، رأيتُ أنَّ المُحقق اتّبع منهج التحقيق القائل بعدم الاقتصار على تحرير النصّ، وإخراجه من المخطوط إلى المطبوع، أي: لا بدّ ـ إضافةً لمقابلة نصّ الكتاب مع نصوص النُّسخ الأُخرى ـ من تخريج النصوص، وشرح الكلمات، وضبط المفردات، وقد بذل جُهداً يُشكر عليه في تحقيقها، وإخراجها بتلك الصورة.
ولكن رأيت أن أُعيد تحقيقها ـ ويبقى له فضل السبق في اختيار هذه الرسالة وتحقيقها ـ لأسباب عدّة.
السبب الأهم في تحقيقي لهذه الرسالة هو استجابة لطلب مؤسسة المرتضـى التي قدّمت لي هذه المخطوطة كممارسة عمليّة لمِا تعلّمته في فن التحقيق. وهناك أسباب أُخرى كُثُر دعتني لإعادة تحقيق هذه الرسالة، أذكرها بين يدي القارئ الكريم، منها:
أوّلاً: فيما يتعلّق بتحقيق المطبوعة
وهو الذي ذُكر على صفحة غلاف النسخة المُحققة المطبوعة (رسالة في عدد قتلة الإمام الحسين×)، وهو يختلف عمّا وضعه المؤلف، وهو (رسالة في عدد المُخْرَجين إلى حرب الحسين× في الطفّ)، وما ذكره المترجمون له من العناوين الأُخرى، مع أنَّ المُحقق قد اطلع على عنوان الرسالة الذي ورد في كتاب: (معجم مؤلفي الكاظميّة)، وهو (عدّة مَن خرج إلى حرب الحسين×، وأنَّهم ثلاثون ألفاً على الأقل).
وهذا تغيير واضح في العنوان؛ إذ مصطلح (القتلة) يختلف عن مصطلح المُخرَجين.
وسيأتي تفصيل ذلك في الحديث عن عنوان الرسالة.
وردت في النُّسخة المطبوعة بعض الأخطاء المطبعية التي لا يفهم القارئ ـ بِسببِها ـ المعنى المراد من الجملة، من قَبيل كلمة (نص) في الجملة: (وما ذكره المسعودي في كتابه إثبات الوصية، الذي نصٌّ على أنَّه له في وفيات الوفيات...)، ورُسمت هكذا (نصٌّ)، وليس لها معنى. والصحيح أن تُبنى للمجهول (نُصَّ)، أي: نصَّ صاحب وفيات الوفيات وغيره على أنَّ كتاب (إثبات الوصية) للمسعودي.
لقد كتب السيّد حسن الصدر+ مجموعة من العناوين، تُحدد بدء المواضيع والمطالب على جوانب المخطوطة، وهي وإن كُتبت في الهامش إلّا أنَّها تُعتبر من أجزاء الرسالة الرئيسة، ويمكن أن تكون عناوين لمطالبها، وهي مما لم تُذكر في المطبوعة.
اكتفى المُحقق بالنُّسختين اللّتين حصل عليهما، وقد وجدت نُسخة أُخرى، وهي مُسَوَّدَةُ هذه المخطوطة، وهي بخط المؤلف.
والتحقيق يتطلّب البحث عن أكثر من نُسخة للمخطوطة.
لم يُنبّه المُحقق على ما ذكره المؤلف (السيّد حسن الصدر+) في هذه العبارة: «وقد رأيت في تاريخ ابن جرير يروي أنَّه [الحسين×]: قتل ألفاً وثمانمائة رجل».
وهذه الجملة لم تُذكر في تاريخ الطبري، وإنَّما ذُكرت في (إثبات الوصية) للمسعودي، فوجب التنبيه على ذلك، وهذا أمر مهم، وهو ما لم يُذكر في هامش المطبوعة.
ويجب التنبيه أيضاً على بعض ما نقله المؤلف، كما في بعض الروايات التي ورد فيها اسم (الحصين بن نمير السكوني)، المذكور بهذا اللقب في كثير من المؤلفات القديمة، كـ (الفتوح) لابن أعثم وغيره، والحديثة أيضاً كما في (أعيان الشيعة).
والصحيح (التميمي) وهو صاحب شرطة عبيد الله بن زياد.
وكذلك ما نقله عن الطبري في اسم (عبد الرحمن بن أبي سبرة الحنفي...) والصحيح (الجعفي) وسيأتي تفصيله.
فقد ذكر المُحقق هامشاً طويلاً بحيث استغرق أكثر من عشـر صفحات؛ ردّاً على قول المؤرخين: (وكان عمر بن سعد يكره قتاله ـ الحسين×ـ).
وإنَّما يُذكر هذا الهامش فيما لو كان موضوع الرسالة يتحدّث عن ترجمة عمر بن سعد (لعنه الله)، أو كان هناك تعليقٌ من المؤلف على هذه العبارة بعد أن استشهد بها.
ومهما يكن فإنَّ هذا الهامش لا علاقة له بموضوع الرسالة الذي يتعلّق بعدد المُخرَجين لحرب الإمام×؛ لأنَّ هذا الأمر يفتح المجال واسعاً للحديث عن كلّ اسم ورد ذكره في الرسالة ووصف بأمر معين.
ثُمّ إنَّ هذه الكلمات وردت في نصّ استشهد به المؤلف، فليست من كلامه ووصفه؛ ليحسن التعليق على كلامه إثباتاً أو نفياً، علماً بأنَّ الهامش جيد، ولكن له محلٌّ آخر.
ثانياً: فيما يتعلّق بمؤلف الرسالة
1ـ في جانب الاستدراك على المؤلف
إذ كان ـ فيما حضر السيّد حسن الصدر+ من الاستنباطات؛ من أجل إثبات عدد الجيش الأُموي أنَّه ثلاثون ألفاً ـ الشاهد الذي ذكره في قول الطرمّاح بن عدي للإمام الحسين×: «... وقدْ رأيتُ قبل خروجي من الكوفة إليك بيومٍ ظَهر الكوفة، وفيه من الناس ما لمْ ترَ عيناي في صعيد واحد جمعاً أكثرَ منه، فسألت عنهم: فقيل اجتمعوا ليُعرضوا، ثُمَّ يُسـرّحُون إلى الحسين»[16].
والاستدراك هنا: إنَّ هناك عرضاً آخرَ للجيش، ومنه سُرّح إلى كربلاء، لم يذكره السيّد حسن الصدر+. وكان في معسكر عبيد الله في النُّخيلة حين قدِم إليها، بعد أن استعمل عمرو بن حريث على الكوفة.
وذكر هذا العرض عبد الله بن عمير من بني عُليم، إذ رأى القوم بالنُّخيلة يُعرضون ليُسرّحوا إلى الحسين×، فسأل عنهم. فقيل له: يُسـرّحون إلى حسين بن فاطمة بنت رسول الله|...[17].
وهذا الشاهد يمكن أن يكون دليلاً آخر على ما أراد المُصنف إثباته، وسيُذكر مفصّلاً.
2ـ جواب لمسألة لم يتعرّض لها المؤلف
وكذلك ذكرنا جواباً لمسألة لم يتعرّض لها المؤلف، ولم يذكرها المؤرخون والمحدّثون، وكذلك المُحققون، وهي أنَّهم حين يتحدّثون عن أعداد الجيش الذي قيل عنه (ثلاثون ألفاً)، يقولون: «وسار ابن سعد إلى قتال الحسين× بالأربعة آلاف التي كانت معه، وانضمّ إليه الحر وأصحابه، فصار في خمسة آلاف، ثمَّ جاءه شمر في أربعة آلاف، ثمَّ أتبعه ابن زياد بيزيد بن ركاب الكلبي في ألفين، والحصين بن تميم السكوني في أربعة آلاف، وفلان المازني في ثلاثة آلاف، ونصر ابن فلان في ألفين، فذلك عشـرون ألف فارس تكمّلت عنده إلى ست ليال خلون من المحرّم، وبعث كعب بن طلحة في ثلاثة آلاف، وشبث بن ربعي الرياحي في ألف، وحجار بن أبجر في ألف، فذلك خمسة وعشـرون ألفاً»[18]. ثمَّ يقولون: «وما زال يُرسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده ثلاثون ألفاً ما بين فارس وراجل»[19].
أقول: لم نجد في جميع المصادر المهمّة التي بين أيدينا مَن عرّف وحدّد هذه (الخمسة آلاف) ـ المكمّلة للثلاثين ـ مع مَن أقبلت؟ ومَن هم قادتها؟
وقد حصلنا على شواهد يمكن من خلالها تحديد أسماء تلك القبائل وقادتها، التي كان عددها خمسة آلاف، وبها يكتمل العدد (ثلاثين ألفاً).
وعسى أن يكون صحيحاً، أو نكون قد سرنا خطوة في تحقيق هذه المسألة.
ثالثاً: المناهج المختلفة في التحقيق
ومن الأسباب التي تدعو إلى إعادة تحقيق بعض المخطوطات المُحقّقة، هو أنَّ المُحقّقين يختلفون في المناهج التي يتبعونها في عمل التحقيق، إذ لو أُعطيت هذه الرسالة لأكثر من مُحقّق لرأيت كلّ مُحقّق يعرض تحقيقه بشكل يختلف عن الآخرين؛ وذلك لأنَّهم يختلفون في الفن والإبداع في التحقيق، ويتفقون على القضايا الرئيسة في تحرير النصّ.
ومن المسائل التي قد يختلف فيها المُحققون في هذه الرسالة ـ على سبيل المثال ـ هو أنَّ هذه الرسالة أُلفت جواباً لسؤال وجّهه السائل ـ وهو السيّد عبد الحسين الكليدار& ـ للمؤلف، فجاء في أوّلها: «سألت (أدام الله توفيقك وزاد في شرفك وعزِّك)...».
وفي النُّسخة المُحقّقة لم نجد ذكراً أو ترجمةً للسائل، ومن هنا قد يختلف المُحققون في هذا الأمر، فهل يتطلّب التحقيق التعريف بالسائل، وذكر ترجمة له؛ باعتباره كان سبباً في تأليف هذه الرسالة، أو أنَّ هذا الأمر ليس من صلب التحقيق؟
وكذلك هناك اختلاف بينهم في المسائل التي تُبحث في المقدّمة، أو في المواضع التي يجب أن يُذكر لها هامش، وأيضاً في الشرح والتعليق، وغيرها من مسائل التحقيق الأُخرى.
وأعتقد أنَّ أيّ مُحقّق له اتجاه وأُسلوب محدد في التحقيق، تُشمُّ منه رائحة فنّه ومنهجه وأُسلوبه، لا يستطيع أن يحيد عنه، فهو كالطبع المتجذر في نفس الإنسان، وأذكّر هنا أنَّ عملي في تحقيق هذه الرسالة لا يعني أنَّه يُغني عن التحقيق الأوّل، فلكلّ تحقيق وجهته، وإن ارتفعا ـ في الجانب الفني والعلمي ـ إلى المستوى المتعارف عليه في التحقيق، فقد يكون كلّ منهما مُكمّلاً للآخر.
هذه جملة من الأسباب التي تُسوّغ إعادة تحقيق هذه الرسالة مرّة أُخرى؛ إحياءً لتراثنا الإسلامي، وخدمةً للعلم والتاريخ، وتخليداً لذكر المؤلف (طيب الله ثراه)، وتحقيقاً في إحدى المسائل في واقعة الطفّ المهمّة، التي تتعلّق بعدد المُخرَجين إلى حرب الإمام الحسين×، وكذلك للمقارنة بين تحقيقين لمخطوطة واحدة في اختلاف مناهج التحقيق وأساليبه.
اختلف المترجمون في تسمية هذه الرسالة، فالسيّد شرف الدين في كتابه (بُغية الراغبين في أحوال آل شرف الدين)، ذكرها بعنوان: (محاربو الله ورسوله يوم الطفوف)، ثمَّ عرّف موضوعها، فقال: «رسالة أفردها لبيان عدد المُخرَجين إلى حرب سيّد الشهداء يوم الطفّ، أثبت فيها أنَّهم كانوا ثلاثين ألفاً أو يزيدون»[20].
وأمّا في الذريعة، فلم يذكر لها هذا العنوان، وإنَّما ذكر تعريفاً بموضوعها، فقال: «رسالة في عدد مَن خرج إلى حرب الحسين×، وإثبات أنَّ المتيقن منهم ثلاثون ألفاً»[21]. وكذلك السيّد الأمين في الأعيان، قال: «عدّة مَن خرج إلى حرب الحسين×، وأنَّهم ثلاثون ألفاً على الأقل»[22].
وواضح أنَّ ما ذُكر في الذريعة والأعيان، هو تعريف بموضوع الرسالة وليس عنواناً، ويبقى تحقيق صحة العنوان الذي ذكره السيّد شرف الدين، وهو (محاربو الله ورسوله يوم الطفوف)، لم نهتدِ إلى المصدر الذي اعتمد عليه&.
وأمّا ما ذكره مُحققو كتب السيّد حسن الصدر+ من عناوين لهذه الرسالة في مقدّمات التحقيق، فقد اعتمدوا على ذات المصادر المتقدّمة.
وأمّا عنوان النُّسخة المُحقّقة، فكان (رسالة في عدد قتلة الحسين)، ولم يذكر معه التعريف المتقدّم، وكذلك لم يذكر عنه شيئاً في مقدّمة التحقيق، وهو وإن كانت فيه دلالة على العموم على نحو المجاز، كما قالوا: (تَتَبَّع المختار قتلة الإمام الحسين×). ويُريدون بذلك جميع مَن استُشهد في واقعة الطفّ، إلّا أنَّه يختلف عن العنوان الذي ذكرته كتب المؤرخين وأصحاب التراجم، وهو (رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين× في الطفّ).
وهذا يخالف منهج التحقيق الذي يلزم النقل الصحيح والكامل، خاصّة لأمر مُهمّ، وهو عنوان الكتاب، وإن كانت فيه دلالة واضحة على نسبة الكتاب لمؤلفه من خلال اسمه المذكور على صفحة الغلاف.
ثمَّ ظاهره ـ لمَن لا يعرف مصطلح المجاز ومعانيه ـ يدلّ على عدد الذين اشتركوا في قتل الحسين× خاصّة، وليس فيه إشارة إلى موضوع عدد المُخرَجين لحرب الحسين×.
وفرق كبير بينهما، فعدد الذين بارزهم الإمام الحسين× وقتلهم، أو الذين انهزموا أمامه، وكذلك كلّ مَن رماه بالنبال والسهام والحجارة، أو مَن وطأ الخيل صدره، وغيرهم من المباشرين في ساحة المعركة قد لا يتجاوز الخمسة آلاف، بينما موضوع الرسالة يتحدّث عن (ثلاثين ألفاً)، وهؤلاء هم المُخرَجون إلى حرب الحسين×.
وأعتقد أنَّ المُحقق لتلك النُّسخة لم يرجع للمصادر المُعتبرة التي تُعرّف هذه النُّسخة، ولعلّه وضع هذا العنوان لمِا ورد في مطلع الرسالة، من قول السائل الذي أشار له السيّد حسن الصدر+: «سألت... عمَّن زاد على أربعة آلاف في عدد المُحاربين في الطفّ لسيّد الشهداء...».
وعند البحث عن نُسخ المخطوطة حصلنا على قرص ليزري من مؤسسة المرتضى في النجف ـ ولم تُذكر فيه إشارة تدلّ على مصدره ـ يحتوي على نُسختين.
أحدهما (المُسوَّدة) لهذه المخطوطة، وأُخرى (المُبيَّضة).
وكذلك لم يُذكر فيهما عنوان لهذه الرسالة، ولكن وجدنا ورقتين مع الرسالة تحتوي كلّ واحدة منهما على أسماء جملة من رسائل المؤلف.
فأمَّا الأُولى: فذكر فيها تسع رسائل، وفي آخرها: «تمَّ بإملاء الأحقر علي نجل المؤلف (طاب ثراه)»، وكان تسلسل عنوان هذه الرسالة فيها هو الثاني، وجاء فيه: «رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين».
وكذلك الورقة الأُخرى: فهي مستقلة، ذُكرت فيها أسماء خمس رسائل فقهية، وفي آخرها كُتب: «كلّها تأليف الأحقر حسن صدر الدين»، وكان تسلسل هذه الرسالة هو الثالث، وجاء فيه: «رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين× في الطفّ». وفي هذا العنوان زيادة، وهي (في الطفّ). والخط الذي كُتبت به الورقة الثانية، هو خط النسخ، وصغير الحجم، وهو يشبه خط مُسوَّدة هذه الرسالة، وعُلم من ذلك أنَّ هذه الورقة كتبها المؤلف+ بخطه.
وهنا اتضحت حقيقة عنوان هذه الرسالة الذي وضعه المؤلف لها، وهو (رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين× في الطفّ)، وهو الذي اعتمدناه في تحقيق هذه الرسالة، وأتبعناه بتعريف موضوعها، وهو خلاصة ما ذكره المترجمون.
ولكن يبقى العنوان الذي ذكره العالم المُحقق السيّد شرف الدين الموسوي، والمصدر الذي اعتمد عليه، وهو ما لم نوفّق لمعرفة حقيقته.
ولا بدّ أن يُؤخذ بعين الاعتبار وأن لا يُهمل؛ إذ قد يكون السيّد حسن الصدر+ أضاف هذا العنوان.
ومهما يكن، فإنَّ له دلالة عقديّة مهمّة، وكأنَّه يُفرغ عن لسان العصمة، وسنتحدّث عن دلالته، وكذلك عن دلالة العنوان الذي وضعه السيّد حسن الصدر+ بإيجاز في هذه السطور الآتية.
دلالة عنوان الرسالة: (محاربو الله ورسوله في يوم الطفوف)
ودلالته تتجسد في حقيقة هؤلاء الذين أُخرجوا لحرب الإمام الحسين×، وأنَّهم قد (حاربوا الله ورسوله يوم الطفوف)؛ بقتالهم ومحاربتهم الإمام الحسين×.
وقبل تفصيل هذه الدلالة وتطبيقها على هؤلاء، نُلقي نظرةً تمهيديةً حول ما خلّفته الأحداث التي جرت في الصدر الأوّل للإسلام.
لقد تركت واقعة السقيفة آثاراً جسيمةً في الدولة الإسلاميّة؛ إذ انقسم المجتمع على أثرها على صنفين:
مثّل الصنف الأوّل الخلفاء الثلاثة، ومَن سار على نهجم، وتمسّك بآرائهم، ومواقفهم، فكان له أثر كبير على المستوى السياسي المتمثّل في منهج الخلفاء في الحكم والسياسة، والذي أدّى إلى تأسيس الدولة الأُمويّة والعباسيّة، وكان لهذا الاتجاه الأثر الواضح في الجانب العسكري، كما حصل في حرب الجمل، وصفّين، والنهروان، وفي واقعة كربلاء.
وأمَّا الصنف الثاني فتمثّل بالثقل الثاني، الذي أوصى النبي| باتّباعه في حديث الثقلين، والمتجسّد بأهل بيت النبي|، وهم الأئمّة الاثنا عشر^.
ولا شكّ في انقسام المجتمع حول هذين الصنفين، فكان للصنف الأوّل محدّثوه ومفسّروه، ومؤرخوه ورواته الذين يدافعون عنه، ويوجّهون مواقفه وتصـرفاته، ويعتبرونه الحقّ الذي يجب اتباعه، ويحتجون لآرائهم بأدلّة وحجج يعتبرونها صحيحة ومقنعة؛ لأنَّها تستند إلى روايات يعتقدون بصحتها، حتى وإن كانت موضوعة ومُحرّفة.
ومن ذلك قولهم إنَّ يزيد هو: (خليفة الله في أرضه، وهو ممثل لإرادة السماء) وعلى هذا يكون كلّ مَن حاربه هو (محارب لله ولرسوله|)، ويستحق القتل لخروجه عن طاعة ولي الأمر يزيد.
فهذا «القاضي أبو بكر بن العربي يفتري بكلّ الصراحة والجرأة، قائلاً: وما خرج أحد لقتال الحسين إلّا بتأويل، ولا قاتلوه إلّا بما سمعوا من جدّه، المهيمن على الرسل، المُخبر بفساد الحال، المُحذّر من دخول الفتن، وأقواله في ذلك كثيرة، منها: قوله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم): إنَّه ستكون هنات وهنات، فمَن أراد أن يُفرّق أمر هذه الأُمّة، وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائناً مَن كان. فما خرج الناس [يقصد القتلة] إلّا بهذا وأمثاله»[23].
بمعنى أنَّ كلّ ما فعله يزيد وزبانيته في كربلاء، كان مجرّد تطبيق لحكم الشـرع على ضوء أحاديث النبي|.
«ولعلّ حسن تطبيق يزيد للشرع، هو الذي جعل محبّ الدين الخطيب أن يصفه بأنَّه كان شخصاً لامعاً، ومكتمل المواهب، ومستكملاً للصفات اللائقة بمهمّة المركز الذي أراده الله له وهو الخلافة. ليس ذلك فقط، فهذا ابن حجر المكي يُقدّم (دليلاً) على اكتمال كمالات يزيد الخُلقية، بقوله: (إنَّ يزيد لمّا وصل إليه رأس الحسين بكى، قائلاً: رحمك الله يا حسين، لقد قتلك رجل لم يعرف حقّ الأرحام)[24]. فيا له من افتراء على التاريخ!
وأمّا الشيخ أبو حامد الغزالي صاحب كتاب (إحياء علوم الدين)، فإنَّه يُريد قتل ومحو أيّ علوم متعلّقة بفاجعة مقتل الحسين× وأهل البيت^، كلية من مصادرها التاريخية، وهذا نصّ ما قال: ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته، وما جرى بين الصحابة، والتشاجر والتخاصم، فإنَّه يهيج على بعض الصحابة، والطعن فيهم، وهم أعلام الدين.
فيالها من فتوى! إنَّه كلام غريب يُشَّم منه رائحة تفوح بوجود مؤامرة حقيقية لدفن الحقائق إن لم يكن تزويرها.
وللقارئ أن يتصوّر سبب غفلة معظم أبناء أهل السنة والجماعة عن مأساة الإمام الحسين× بصورة خاصّة، وأهل البيت^ بصورة عامّة.
وعلى كل حال، فإنَّ الغزالي يعترف أنَّ جريمة قتل الحسين×، وتشاجر الصحابة، وتخاصمهم مع بعضهم مدعاة للبغض والطعن فيهم، وأفعالهم تلك المشابهة لهذه، هي فعلاً محلّ للبغض والطعن.
وأمّا قوله إنَّهم أعلام الدين! فهذا يُعدُّ تناقضاً عجيباً، لا يمكن أن يقبله عقل سليم»[25].
هكذا استدلت هذه الجهة على أنَّ عمل يزيد كان تطبيقاً للشـريعة الإسلاميّة في قتله للإمام الحسين×؛ وحينئذٍ يكون كلّ مَن حاربه، فهو (محارب لله ولرسوله|).
وهناك شواهد كثيرة على تعظيم هذه الجهة ليزيد، وأنَّه خليفة الله ورسوله، ولكن استدلالهم هذا لن يتمّ إلّا عبر تحريف الحقائق، وتزوير التاريخ، وإخفاء البيّنات والدلائل الواضحات.
وبعد هذه الإطلالة السريعة على حوادث صدر الإسلام، لننظر تطبيق عنوان هذه الرسالة: (محاربو الله ورسوله يوم الطفوف)، وأحقيته في الدلالة على أتباع يزيد بن معاوية في واقعة الطفّ، كما تقول الشيعة.
استوحى واضع هذا العنوان من الأحاديث النبويّة المقدّسة، التي هي واضحة الدلالة، ظاهرة المعنى في تطبيق العنوان المستوحى منها على أتباع يزيد في واقعة الطفّ... فقد روي عن زيد بن أرقم أنَّ النبي| قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمَن حاربتم وسلم لمَن سالمتم»[26].
فأمّا الإمام علي×، فالأحاديث كثيرة ومتواترة حول هذا المعنى، ومنها: «يا علي، حربك حربي...»[27].
وأمّا السيّدة فاطمة الزهراء‘، فقوله’: «فمَن آذاها فقد آذاني...» [28]. وأمَّا الإمام الحسن والحسين÷، فقوله’ في هذا الحديث المتقدّم، وله مصادر جمّة، فقد رواه الحاكم[29]، وقال: وله شاهد عن زيد بن أرقم، عن النبي|، أنَّه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين: «أنا حرب لمَن حاربتم وسلم لمَن سالمتم». ورواه الطبراني[30] بإسناده، عن أبي هريرة، قال نظر النبي| إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: «أنا حرب لمَن حاربكم وسلم لمَن سالمكم».
ورواه أحمد بن حنبل[31]، والخطيب[32]، عن أبي هريرة، قال: نظر رسول الله| إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: «أنا حرب لمَن حاربكم سلم لمَن سالمكم». ورواه الحافظ ابن شاهين في رسالته التي ألّفها في فضائل فاطمة بنت رسول الله|. عن أبي سعيد الخدري، قال: «لمّا دخل علي بفاطمة جاء النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أربعين صباحاً إلى بابها، فيقول: أنا حرب لمَن حاربتم وسلم لمَن سالمتم»[33].
وبهذه الأحاديث المستفيضة في كتب العامّة استدل الشيعة على دلالة هذا العنوان، وتطبيقه على يزيد واتباعه، الذين حاربوا الإمام الحسين× في واقعة الطفّ.
ودلالة الحديث واضحة وليست فيها إبهام أو غموض في أنَّ محاربة الحسين× هي محاربة لجدّه المصطفى|، وهو كفر بالإجماع. وكذلك قوله في الحديث: «ستة لعنتهم، لعنهم الله وكلّ نبي مُجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذّب بقدر الله تعالى، والمتسلّط بالجبروت، فيُعِزُّ مَن أذل الله، ويُذلّ مَن أعزّ الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرّم الله، والتارك لسنتي»[34]. قال المناوي في شرحه: «(والمستحل من عترتي ما حرّم الله): يعني مَن فعل بأقاربي ما لا يجوز فعله، من إيذائهم، أو ترك تعظيمهم.
وخصَّ الحرم والعترة باللعن؛ لتأكد حقّ الحرم والعترة، وعظم قدرهما بإضافتهما إلى الله وإلى رسوله»[35].
فما تقدّم يُثبت أنَّ يزيد وأتباعه هم مَن حاربوا رسول الله|، بعد أن آذوه في قتل الحسين× وأهل بيته وأصحابه، وسبوا نساءه، وهذا إيذاء لرسول الله| ومحاربة له.
وقد نصّ القرآن على عاقبة كلّ مَن يؤذي رسول الله|، قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) [36].
دلالة العنوان: (عدد المُخرَجين إلى حرب الحسين× في الطفّ)
إنَّ اختيار السيّد حسن الصدر+ لمصطلح (المُخرَجين) هو اختيار لافتٌ للنظر؛ إذ لم يرد هذا المصطلح في كتب المؤلفين، ولم يُذكر عنهم أنَّهم اصطلحوا على أُولئك الذين قاتلوا الإمام الحسين في واقعة كربلاء (بالمُخرَجين).
وهو بذلك يُريد أن يُؤكّد على أنَّ أغلبية هؤلاء أُجبروا على القتال في كربلاء، وأُخرجوا كرهاً إلى هذه الحرب، وفُرض عليهم الاشتراك فيها.
وهذا لا يعني عدم وجود أفراد من الجهة الأُخرى، وهي التي خرجت طوعاً، أو لأسباب أُخرى لهذه الحرب، ولكن الظاهرة العامّة في هذا الجيش هو أنَّه أُخرج كُرهاً لهذه الحرب.
والشواهد على ذلك كثيرة.
فأمّا قادة العسكر، فأميرهم عمر بن سعد، كان كارهاً للاشتراك في هذه الحرب، وحاول بمختلف الوسائل إقناع عبيد الله بن زياد في العدول عن رأيه، ولكنّه لم يُفلح في ذلك.
وكذلك ما نُقل عن شَبَث بن ربعي، في قوله: «إنّا قاتلنا مع علي بن أبي طالب، ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان خمس سنين، ثمَّ عدونا على ابنه، وهو خير أهل الأرض، نقاتله مع آل معاوية، وابن سمية الزانية، ضلال يا لك من ضلال!»[37].
وأمّا كراهة أفراد الجيش للقتال:
فقد نقل الدينوري صورةً تُوضّح كرههم للقتال، وأنَّهم أُخرجوا بالقوة، فقال: «قالوا: وكان ابن زياد إذا وجّه الرجل إلى قتال الحسين في الجمع الكثير، يصلون إلى كربلاء، ولم يبقَ منهم إلّا القليل، كانوا يكرهون قتال الحسين، فيرتدعون، ويتخلّفون»[38].
ولا شكّ في وجود الجهة الثانية، وفيها أصناف متعدّدة:
فمنهم: القبائل التي كان همّها أن تحصل على أكثر عدد من رؤوس القتلى.
ومنهم: المتطوعون في هذه الحرب؛ نصباً وكُرهاً وبُغضا لأهل البيت^.
وكذلك مَن خرج للشهرة والجاه والمنصب؛ من أجل أن يحظى بمنزلة عند عبيد الله بن زياد أو يزيد، لا سيّما قادة القبائل.
والخلاصة: إنَّ هذا العنوان (عدد الذين أُخرجوا لحرب الحسين× في الطفّ)، يُعرّف ـ بدلالة واضحة ـ أغلبية ذلك الجيش، وأنَّه أُخرج كُرهاً، فصحّ أن يُصطلح على تلك الجيوش بـ(المُخرَجين) لحرب الحسين×.
وهنا يجبُ أن نذكّر عند المقارنة بين الجيشين؛ إذ يتجلى الحقّ بأروع صورة، والعدل في أجمل مثال.
فالذين أُخرجوا للحرب مع عمر بن سعد، كرهوا القتال؛ لأنَّهم علموا أنَّهم بقتالهم للإمام الحسين×، إنَّما يقاتلون الله ورسوله ويحاربونهما.
فالحسين× سيّد شباب أهل الجنّة، كما في الحديث المتواتر عند أبناء العامّة وغيرهم، ولا شكّ أنَّ حديث النبي في الحسين وأخيه÷: «أنا حرب لَمن حاربكم وسلم لَمن سالمكم»، تناهى إلى سمعهم، ومنه كرهوا قتال الحسين×. بينما الذين اشتركوا مع الإمام الحسين×، إنَّما جاؤوا طوع إرادتهم، فالإمام الحسين× ومنذُ خروجه من مكة المكرّمة، إلى أن وصل إلى كربلاء، يُخبر جميع مَن التحق به بأنَّه مُقبل على الشهادة، وكان يُكرر ذلك دائماً، وبقى حتى ليلة العاشر من المُحرّم يُخيّر أصحابه، فقال لهم: «هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً...»[39]. وقد عرفوا الحقّ في تلك المعركة، فآثروا اتّباعه، ومن هنا كانت نواياهم خالصة لا يشوبها شيء، فلن يتسـرّب الشك في أنَّهم لحقوا الإمام الحسين× من أجل مكاسب ماديّة أو دنيويّة.
ويبقى أمر آخر في دلالة هذا العنوان، وهو الحديث عن عدد أفراد ذلك الجيش وأسباب كثرتهم، وسيأتي تحقيق ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب.
نسبة الرسالة إلى مؤلفها السيّد حسن الصدر+
كُتبت هذه الرسالة جواباً لسؤال وجّهه خازن الروضة الحسينيّة، كما جاء في مطلعها، وذكر تاريخ كتابتها في آخر الرسالة، حيث قال: « حرره... حسن صدر الدين الموسوي الكاظمي، في ساعتين من نهار الجمعة، حادي عشـر مُحرّم الحرام، سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف ـ 1334هـ».
وتنشأ أهميّة البحث عن نسبة هذه الرسالة إلى مؤلفها الكريم ـ مضافاً إلى كونه من ضروريات التحقيق ـ من شبهة، حاصلها: إنَّ السيّد حسن الصدر+ لم يذكرها ضمن مؤلفاته التي كتبها في ترجمته لشخصه الكريم في (تكملة أمل الآمل)، مع أنَّ إتمام المجلد الأوّل من التكملة كان في صفر سنة (1335هـ)، أي: بعد تأليفه هذه الرسالة.
كما أنَّ تلميذه وابن أُخته الشيخ مرتضى آل ياسين&، وهو ممّن ترجم له، كذلك لم يذكر هذه الرسالة.
ولكن سنُثبت إن شاء الله أنَّها من تأليف السيّد حسن الصدر، كما سيأتي، وأنَّها أُلفت قبل تبييض المجلد الأوّل من (التكملة) كما تقدّم.
ولعلّ السيّد+ لم يذكرها ضمن مؤلفاته؛ لأنَّه لم يعتبرها كتاباً أو مؤلفاً يستحق أن يُدرج ضمن سلسلة المؤلفات ـ وإن ذكرها في الورقة المتقدّمة ـ وذلك لأنَّها جواب على رسالة، وكذلك لصغر حجمها، وأيضاً للمدّة الزمنية التي كُتبت فيها هذه الرسالة، وهي (ساعتان).
وهذا يدلّ على أنَّه كان مثالاً في التواضع؛ ولهذا السبب أيضاً سار على نهجه الشيخ مرتضـى آل ياسين، فلم يذكرها في مؤلفاته ورسائله، أو نقول: إنَّ الشيخ لم يطّلع عليها.
وأمّا بعد معرفتها والاطلاع عليها ـ من جهة السيّد عبد الحسين خازن الروضة الحسينيّة، ومما خلّفه السيّد حسن الصدر+ ـ أُدرجت حينئذٍ ضمن مؤلفاته.
وهذا ما ذهب إليه السيّد شرف الدين العاملي في كتابه (بُغية الراغبين في أحوال آل شرف الدين)، فقد ذكرها ضمن مؤلفاته في التسلسل: (78)، فقال: «(محاربو الله ورسوله يوم الطفوف)، رسالة أفردها لبيان عدد المُخرَجين إلى حرب سيّد الشهداء يوم الطفّ، أثبت فيها أنَّهم كانوا ثلاثين ألفاً أو يزيدون»[40].
وكذلك ذكرها كلّ مَن جاء بعده، كالسيّد محسن الأمين في (أعيان الشيعة)، وكانت في التسلسل (51) بعنوان: (عدّة مَنْ خرج إلى حرب الحسين×، وأنَّهم ثلاثون ألفاً على الأقل).
ويؤكّد نسبة الرسالة هذه للسيّد الصدر& أيضاً أُمور:
الأوّل: ذكر اسم السائل في مطلع الرسالة وآخرها، وهو السيّد عبد الحسين خازن الروضة الحسينيّة، وهذا دليل على شهرتها.
الثاني: ذكر المؤلف اسمه في خاتمة الرسالة، وتنبيهه عليها في الورقة التي وجدت مع هذه المخطوطة، إذ كُتبت عليها أسماء خمسة من رسائل السيّد حسن الصدر+، وكان عنوان هذه الرسالة، هو التسلسل الثالث بعنوان: (رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين في الطفّ)، وفي آخر العناوين كتب: «كلّها تأليف الأحقر حسن صدر الدين».
كما أنَّ الخط الذي كُتِبت فيه الرسالة يُشابه إلى حدّ كبير خط السيّد المؤلف+، وهو خط النسخ صغير الحجم، وهو عينه الذي كُتبت به الورقة المُتقدّمة.
الثالث: إنَّ المعوَّل عليه في التأكيد على هذه النسبة، والمصدر الذي يُرجع إليه في تحديدها، هو الشيخ آغا بزرك الطهراني+، فهو خرّيت هذه الصنعة.
ثمَّ إنَّه كان صاحبه ورفيقه، ومن المقرّبين إليه، والمتردد دائماً على مكتبته، حتى أنَّه قال: «وكنت أُشاطره في أعماله، وأُزاول كتاباته وتآليفه، وأُساعده على بعض مهماته العلميّة، وكنت يوم تأليفه (التكملة) أعينه على جمعها، فإنَّ على هوامش نُسخته الأصلية كثير من التراجم بخطي بما أملاه عليّ فكتبته، أو كتبته وعرضته عليه فأمضاه، كما ذكرته في الذريعة»[41].
وقد نسب الطهراني هذه الرسالة إلى السيّد حسن الصدر+، فقال في الذريعة: «(رسالة في عدد مَن خرج إلى حرب الحسين×)، وإثبات أنَّ المُتيقّن منهم ثلاثون ألفاً. لسيّدنا أبى محمد الحسن بن السيّد هادي آل صدر الدين العاملي الكاظمي، المتوفى (1354هـ).
كتبها بالتماس السيّد عبد الحسين الكليدار بن علي بن جواد، خازن الحضـرة الحسينيّة. أوّلها: (الحمد لله حمد الشاكرين على مصابهم...)، فرغ منها (1334هـ)»[42].
ولكن اللافت للنظر أنَّ الطهراني لم يحدد أماكن وجود نُسخها، كما هي طريقته في تعريف الكتب والمخطوطات في (الذريعة)، ولا نعلم ما هو السبب؟!
وبهذا يحصل الاعتقاد بصحة نسبة هذه الرسالة إلى مؤلفها، وهو السيّد حسن الصدر+.
وحينئذٍ عرفت علّة عدم ذكر بعض مَن ترجم له هذه الرسالة ضمن مؤلفاته.
ومما تقدّم من تحقيق هذه النسبة يُغني عن تفصيل الحديث عن خط المؤلف، وذوقه الأدبي، ومنهجه في التأليف، التي قد يُستدل منها على هذه النسبة[43].
صنّف السيّد حسن الصدر+ بعض مؤلفاته ورسائله استجابةً لأسباب مهمّة، كالتي تتعلّق بالدفاع عن مذهب الإماميّة؛ إذ كان يهتم للأُمور العامّة التي تخصّ مذهب الإماميّة وترفع من شأنه، ومن هذا الباب كان كثير الإصرار على الشيخ آغا بزرك الطهراني، وتشجيعه في إنجاز موسوعته (الذريعة).
وكذلك حينما وضع جرجي زيدان كتابه: (تاريخ آداب اللغة العربية)، لم يُنصف الشيعة كما ينبغي، فقال ما خلاصته: «الشيعة طائفة صغيرة! لم تترك أثراً يُذكر! وليس لها وجود في الوقت الحاضر!»[44].
فاعتزم نفر من علماء الشيعة التصدي لكتابه هذا، فاتفقوا على أن يقوم ثلاثة منهم بثلاثة أعمال، وهم:
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في تأليفه (النقود والردود)، وفيه أظهر هفوات كتاب جرجي زيدان، وأغلاطه، ونقائصه، وفي الجزء الثاني ذكر أخطاءه، والشيخ آغا بزرك في تأليفه (الذريعة إلى تصانيف الشيعة).
وأمّا السيّد حسن الصدر، فقد ألف كتاباً في تأسيس الشيعة للعلوم الإسلاميّة، الذي طُبعت خلاصته سنة (1331هـ)، بعنوان (الشيعة وفنون الإسلام).
ثمَّ قام ابنه السيّد محمد ـ بعد وفاة أبيه ـ بطبع الكتاب، بتشجيع من صاحب الذريعة[45].
ومن هذا الباب ما ألفه جواباً لسؤال وجّه إليه، كما ذكر ذلك في الترجمة التي كتبها عن نفسه الكريمة في معرض ذكره فهرس تصانيفه، فقال: «وكتاب (نزهة أهل الحرمين في تواريخ تعميرات المشهدين النجف وكربلاء)، كان قد سألني ذلك بعض الأجلّة».
ومن هذا القسم هذه الرسالة: (رسالة في عدد المُخرَجين إلى حرب الحسين× في الطفّ)، فقد كتبها جواباً لسؤال وجّهه إليه خازن الروضة الحسينيّة عن عدد الذين أُخرجوا لحرب الإمام الحسين×، وقد أشار لذلك صاحب الذريعة، فقال: «كتبها بالتماس السيّد عبد الحسين بن الكليدار علي بن جواد، خازن الحضـرة الحسينيّة»[46].
ومن متطلبات التحقيق هنا ذكر ذرو[47] من ترجمة للسائل:
ترجمة السيّد عبد الحسين الكليدار خازن الحضرة الحسينيّة
وهو أحد علماء السادة (آل طعمة)[48] ووجهائهم، وهم من أقدم الأسر العلميّة التي قطنت كربلاء، ووُفّقت لخدمة قبر جدّها الإمام الحسين×، ولهذا لُقّب بـ(الكليدار)، وهي كلمة فارسية الأصل مؤلفة من كلمتي: (كليد) بمعنى المفتاح، و(دار) بمعنى مالك، ومعناها: حامل المفتاح.
ترجم له المؤرخ المُحقق السيّد سلمان هادي آل طعمة في كتابه (تراث كربلاء)، جاء فيها: «عاشرته السنوات الأخيرة من حياته (1375 ـ 1380هـ)، وكان العامل الأوّل في رسوخ معاشرته النبل الذي يحمله، والعاطفة الرقيقة التي يتحلّى بها، فكان مثال الإنسان الوديع على نحافة جسمه، وجهورية صوته، وإشراق وجهه، وكان المتواضع الذي تداخل الزهد معه، وكان على جانب عظيم من الذكاء الحاد، والحس المتوقّد، والخلق القويم...»[49].
وذكر نصاً من أحد المؤلفات التي ترجمت له (أعيان الشيعة)، نذكر منه ما نصّه: «ولد في كربلاء سنة (1299هـ)، وتوفِّي فيها سنة (1380هـ)، ودُفن في أحد حجرات الصحن الحسيني الشريف.
انتقلت إليه سدانة الروضة الحسينيّة سنة (1318هـ) بعد وفاة والده، حتى سنة (1343هـ) حينما رغب في الاعتكاف والانزواء... ولقد كان باحثاً مُحقّقاً يميل بطبعه إلى التتبع في بطون الكتب التاريخيّة والفلسفيّة؛ نتيجة لدراسته وتربيته الأوّلية في حجر أبيه، وما كان يُحيط به من جو علمي أدبي، وقد اشترك في كثير من المؤتمرات التي عُقدت، والحركات التي أُثيرت في كربلاء وبغداد أبان الثورة العراقية سنة (1920م).
ولم يترك البحث التاريخي والأدبي العلمي؛ حيث استطاع أن يُصنّف بعض المؤلفات المُفيدة، ويجمع مكتبةً قيّمةً كانت تُعدُّ من أضخم المكتبات في كربلاء، سواء في مخطوطاتها، أو مطبوعاتها، ولكنّها احترقت في عام (1333هـ) إثر الثورة التي نشبت في كربلاء في هذه السنة بين أهالي كربلاء والسلّطة التركية فيها»[50].
«تتلمذ عليه كلّ من الأُستاذ الأديب أحمد حامد الصـرّاف، مؤلف كتاب (عمر الخيام)، و(الشبك)[51]، وكان حاكم كربلاء الأسبق، وكذلك الأُستاذ محمد حسين الأديب، مدير مدرسة الحسين الابتدائية، وكذلك السيّد سلمان هادي آل طعمة»[52].
وقال عنه السيّد صالح الشهرستاني: «كنت لا أنقطع عن زيارته يومياً... وكنت استزيد من مجالسه العامرة، وأحاديثه الطيبة، علماً وأدباً وأخلاقاً... كما كان يرشدني إلى كثير من المصادر والكتب والمكتبات؛ لمراجعتها فيما كان يتعذّر الحصول عليه في مكتبه»[53].
ومما ذُكر في تعريفه أنَّه كان أحد العلماء والمُحققين وله منزلة علميّة واجتماعيّة كبيرة، فقد أثنى عليه السيّد حسن الصدر في آخر الرسالة ووصفه بـ (السيّد الأجل)، فقال: «... وليكن بهذا كفاية لسيّدنا الأجل (أدام الله سُبحانه تأييده)، فقد فُتح له باب تحقيق الحقّ في هذا الباب...».
ومن بعض أقوال السيد الصدر يُعرف بأنَّه كانت لديه القدرة على البحث والتحقيق؛ إذ جاء في آخر هذه الرسالة طلب السيّد حسن الصدر+ منه متابعة البحث والتحقيق في هذا الموضوع، بعد أن رسم له منهج البحث، ومسار التحقيق، فقال: «فعليه (أدام الله توفيقه) أن يبحث عن عدد العشائر والطوائف المذكورة، وسائر الدلائل والإشارات التي جمعتها له، فإنِّي لا يسعني الوقت لبذل الجهد في الأخذ بمجامع هذه الأشياء على التفصيل، وأعتذر إليه من التقصير، فإنِّي كما لا يخفى عليه في شغل شاغل عن ذلك، والسلام».
ويمكن أن نتعرّف عليه أيضاً مما ورد في (الذريعة)؛ حيث جاء فيها:
أوّلاً: كان مهتماً بالمخطوطات وكتابتها، قال في الذريعة: «مقصد أشياء وفقى در تحصيل مرام رتقي وفتقى) فارسي، للسيّد غياث الدين الأصفهاني، نُسخة ناقصة بقلم السيّد عبد الحسين بن علي بن جواد الحسيني[54]، خازن الحضرة الحسينيّة»[55].
ثانياً: لديه مكتبة عامرة بالكتب والمخطوطات، فقد ذكر صاحب الذريعة جملة من الكتب والمخطوطات في مكتبته، ومما شاهده منها على سبيل المثال: «ديوان الشيخ محمد علي كمونة»[56]، «الكشكول للمولى محمد حسين بن كرم علي الأصفهاني»[57]، «مفاتيح المغاليق في علم الأعداد والحروف»[58].
وكذلك كانت فيها النُّسخة الأصلية لـ «ملحمة الشاعر الكبير جواد بدقت الكربلائي»[59].
نُسخ الرسالة ومنهج تحقيقها
أوّلاً: تعريف بنسخ الرسالة المخطوطة والمطبوعة
لقد ذكرنا أنَّ الشيخ آغا بزرك الطهراني لم يذكر في الذريعة مصدر هذه المخطوطة، واقتضى الأمر أن نبحث عنها في مظانها.
وقد ذكر مُحقق هذه المخطوطة منتظر الحيدري، أنَّه حصل على قرص ليزري فيه كتب السيّد حسن الصدر+، وذكر أنَّه وجد فيه نُسختين لهذه المخطوطة.
وكذلك حصلنا على قرص ليزري من خلال مؤسسة المرتضى على نُسختين، اتّضح أنَّ إحداهما: هي مما اعتمد عليها المُحقق. والثانية: هي مُسوَّدة هذه المخطوطة، ومعها ورقتان منفصلتان.
ولا شكّ أنَّ هناك نُسخة أُخرى لم نستطع الحصول عليها، وهي التي وصلت السائل، وهو السيّد عبد الحسين الكليدار آل طعمة.
ويُعتقد أنَّ هذه الرسالة كانت في مجلّد ضمَّ مجموعة[60] من رسائل السيّد حسن الصدر+؛ إذ جاء في الورقة الأُولى المستقلة مع هذه المخطوطة: «مجموعة رسائل من تأليف سيّدنا حجّة الإسلام والمسلمين آية الله في العالمين سيّدي الوالد، السيّد حسن، المشتهر بالسيّد حسن صدر الدين+:
1ـ الغالية لأهل الأنظار العالية، وهي رسالة فارسية في حرمة حلق اللحية.
2ـ رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين×.
3ـ رسالة مختصر (محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل).
4ـ تعليقة على بعض مبحث القطع من رسائل الشيخ+.
5ـ رسالة في الشكوك الغير منصوصة.
6ـ رسالة في حجّية الظنّ في الركعات وأفعال الصلاة.
7ـ نفائس المسائل، وهي تشتمل على مُهمات المسائل الفقهيّة.
8ـ مصابيح الإيمان في حقوق الإخوان.
9ـ كتاب خُلاصة النحو.
تمَّ بإملاء الأحقر علي نجل المؤلف (طاب ثراه)».
وفي الورقة الثانية جاء فيها:
«1ـ نفايس المسائل الفقهيّة.
2ـ رسالة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين في الطفّ.
3ـ حواشي على بعض رسائل البراءة من رسالة الشيخ المرتضى.
5ـ دليل جواز الصلاة في مشكوك الحلية.
كلّها تأليف الأحقر حسن صدر الدين».
وكُتبت الورقة الثانية بخط يُشْبِه خط مُسوَّدة هذه الرسالة.
النُّسخ المعتمدة في تحرير المخطوطة
ومن هنا نكون قد اعتمدنا على أربعة نُسخ، وإليك خصائصها:
الأُولى: (المُسوَّدة)، وهي بخط المؤلف، وكُتبت بخط النسخ بحجم صغير، ولا يمكن تحديد عدد الأسطر؛ لأنَّها مُسوَّدة، وتختلف من صفحة لأُخرى، إضافة للهوامش التي كُتبت على جانب الصفحة، ولكنّها تتعدى الثلاثين سطراً، وهي في ست صفحات، وعُرفت المُسوَّدة من خلال كتاباتها؛ إذ وضع خطاً على بعض الأسطر دلالة على حذفها، ثمَّ استدرك على بعض مواضيعها في الهامش في جوانب الصفحة، وكذلك وُضِعَتْ خطوط حُمْرٌ أسفل كلّ كلمة كُتبت خطأ، أو امتزجت بكلمة أُخرى حتى تُصحح في المُبيَّضة، وهي كما النُّسخ الأُخرى كُتبت لمواضيعها عناوين على هوامش الصفحة توضّح بدء مطالبها، وكُتبت بخط أحمر، وهذه لم نجعلها أصلاً وأُمّاً للنُّسخ؛ لأنَّها مُسوَّدة، ورمزنا لها بالحرف (س).
الثانية: المُبيَّضة، وكُتبت بخط النسخ، وهو واضح ومقروء، وتُدلل على أنَّ كاتبها يحترف الكتابة.
وكانت في تسع صفحات، وكلّ صفحة تحتوي على ثمانية عشـر سطراً، وهذه لم يُكتب في جوانب الصفحة إلّا العناوين، وكُتبت بخط أحمر جميل وواضح ومقروء، وكذلك وضعت أقواس بنفس اللون في بدء كلّ موضوع يُراد التنبيه عليه، كما في قوله (تنبيه)، فكانت بلون أحمر، وكذلك وضعت بعض الخطوط الحُمْر تحت بعض الكلمات؛ تنبيهاً على خطأ فيها، كما في كلمة (الرمات)، أو تنبيهاً على الكلمات التي امتزجت. وهذه النُّسخة مع أنَّها لم تسلم من الأخطاء، ولكنَّها قليلة، ففي الصفحة الأُولى من الرسالة جاء في العنوان ما نصّه: «نقل كلام محمد بن طلحة، أنَّهم عشـرين ألفاً» والصحيح (عشـرون ألفاً)، ولم يذكر اسم كاتبها في نهاية الرسالة، ورمزنا لها بالحرف (م).
وقد تقدّم في تعريف (عنوان الرسالة)، ذكر صفحة مستقلة وجدت مع المخطوطة، فيها تعريف ببعض رسائل السيّد حسن الصدر+، وعددها تسْعُ رسائل، جاء في آخرها: «تمَّ بإملاء الأحقر علي نجل المؤلف (طاب ثراه)».
وقد كُتبت بخط يختلف عن خط النُّسخة المُبيَّضة؛ حيث كُتبت بخط رقعة واضح وجميل.
ويُعتقد أنَّ كاتب هذه الرسالة ومُبيَّضها عن مُسوَّدة السيّد حسن الصدر+، هو السيّد أحمد المرعشـي، ولا بأس بالترجمة له؛ لعلاقته بموضوعنا، وهو تحقيق هذه الرسالة.
السيّد أحمد المرعشي كاتب مؤلفات السيّد حسن الصدر+ وناسخها
وهو السيّد أحمد بن السيّد سلطان على بن ميرزا أبى طالب، بن ميرزا عبد الكريم خان بن الميرزا السيّد على المرعشي التستري، والد السيّد ميرزا إسحاق، وميرزا أبى الفتح خان، المقتول سنة (1209هـ). له كتاب بعنوان: (تكملة الإسماعيليّة في أنساب السادات المرعشيّة). وهو عمُّ والد سماحة آية الله السيّد رضا المرعشي (دام ظله) بن السيّد جعفر ابن السيّد محمد، بن السيّد سلطان علي المرعشي[61].
وكان السيّد أحمد هذا ورعاً صالحاً، تقياً معمّراً، حسن الخط، كتب القرآن الشـريف بخطه عدّة مرّات، ووقفها للمشاهد المشرّفة، ثمَّ اتصل بالسيّد حسن صدر الدين ـ صاحب هذه الرسالة التي نحن بصدد تحقيقها ـ فنزل داره، وكان يُبيِّض له مُسوَّدات تصانيفه، والتي منها (تكملة الأمل) في ثلاث مجلدات.
ولمّا تُوفِّى السيّد الصدر سنة (1354هـ)، كان السيّد أحمد ببغداد في دار خَلَفه الأكبر السيّد محمد الصدر، رئيس مجلس أعيان العراق آنذاك، وبقيَ فيها إلى أن تُوفِّى هناك سنة (1356هـ)[62].
أقول: وهناك دليل آخر يوضّح أنَّ المُسوَّدة كانت بخط المؤلف السيّد حسن الصدر+، والمُبيَّضة بخط السيّد أحمد بن السيّد سلطان، وهو كتابة الأرقام والأعداد، فقد كُتبت في المُسوَّدة برسم عربي، بينما كُتبت في المُبيَّضة برسم فارسي لا سيّما الأرقام (4)، و(5)، و(6).
الثالثة: المُصحّحة، وهي النُّسخة الثانية التي اعتمدها المُحقق الأُستاذ منتظر الحيدري، وكاتب هذه النُّسخة اعتمد المُسوَّدة أصلاً له، وأمَّا التصحيح فعُرف من خلال إضافة الأحرف المشدّدة على بعض الكلمات، مثل: (جهّز)، و(حزّب)، أو استدراك بعض الكلمات.
وهي أيضاً تُشْبِهُ النُّسخ الأُخرى، فقد وضعت لها العناوين في جانب الصفحة، وكذلك كُتبت بخط النسخ وبحجم صغير، إلّا أنَّه واضح ومقروء، وحجم هذه النُّسخة يختلف عن المُبيَّضة؛ إذ الأخيرة تنتهي أسطرها في آخر الصفحة، بينما تلك تنتهي بخمسة أسطر، ولم يذكر اسم ناسخها. ورمز لها بالحرف (ص)، وكذلك كُتبت الأعداد والأرقام فيها برسم فارسي.
الرابعة: المُحقّقة، وهي النُّسخة التي طُبعت بتحقيق منتظر الحيدري، وتقدّم ذكر أوصاف النُّسخ التي اعتمد عليها، وهما: (المُبيَّضة، والمُصحَّحة)، وكانت بعنوان (رسالة في عدد قتلة الإمام الحسين×)، ورمز لها بحرف (ق).
1ـ إنَّ الاختلاف بين هذه النُّسخ قليل، ويكاد يكون مُتشابهاً في النُّسخة المخطوطة، ومهما يكن فقد جعلنا النُّسخة (ص) المُصححة أصلاً في مقابلتها على النُّسخ الأُخرى، وذكرنا ما جاء من اختلاف النُّسخ الأُخرى في الهامش.
2ـ وضع السيّد حسن الصدر+ جملة من العناوين لمواضيع الرسالة، ومطالبها في الهامش على جانب الصفحة، وقد أثبتناه في نصّ الرسالة، وهي تغني عن إضافة عناوين أُخرى. وهذا مما لم يُذكر في المطبوعة.
3ـ أمّا ترجمة الأعلام، فكما تقدّم، ذُكرت في الفصل الرابع، وكانت مُختصـرة، ومَن أراد التفصيل، فعليه بكتب التراجم والسير.
4ـ أرجعنا الشواهد والنصوص إلى مصادرها، وقد كان جُلّها من كتب العامّة.
5ـ ذكرنا جملة من التعليقات المهمّة، التي هي إمّا تصحيح لخطأ، أو سهو في النقل، أو توضيح، أو ذكر فائدة مهمّة تتعلّق بصُلب الموضوع، أو لأنَّ ذكرها من مقتضيات التحقيق.
وأمّا العناوين التي فيها تفصيل، فقد فصّلنا الحديث عنها في الفصل الثاني الذي خُصّص لها، وأردنا من ذلك أن لا نُثقل صفحات متن الرسالة.
6ـ وضعنا في آخر الرسالة فهرساً للعناوين وآخر للمصادر.
وقد انتظمت هذه الرسالة وتحقيقها بعد هذه المقدّمة في أربعة فصول:
الفصل الأوّل: وفيه ترجمة مؤلف الرسالة السيّد حسن الصدر+، وجملة من المسائل التي تتعلّق بالمخطوطة وتحقيقها.
الفصل الثاني: وفيه تعريف بموضوع الرسالة، وبمنهج المؤلف، والنتائج التي تُوصّل إليها، وكذلك تحقيق لبعض المسائل التي وردت في الرسالة، مع إضافة أُمور لم يتعرّض لها المؤلف+، وهي من صُلب الموضوع وقواعده.
الفصل الثالث: وفيه نصّ الرسالة.
وأمّا الفصل الرابع: فكان لضبط الغريب الذي ورد في نصّ الرسالة.
ونهجت فيه على منوال الشيخ السماوي في كتابه (إبصار العين في أنصار الحسين)، واشتمل على تراجم مُختصرة، ومعاني مصطلحات، وتعريف للبلدان.
واقتصرت على عمل فهرسين في خاتمة التحقيق:
أحدها للمصادر التي اعتمدتُها فيه.
ويليه آخر للعناوين.
وحجم الرسالة، وقلّة صفحاتها، أغنى عن عمل فهارس أُخرى، كالتي تُنظّم للأعلام، والأمكنة، وغيرها.
وفي نهاية هذه المقدّمة أُذكّر بأُمور:
أوّلاً: أردت من تحقيق هذه المخطوطة تطبيق ما أخذتُه عن أساتذتي في فن التحقيق، وعلى رأسهم العلّامة المُحقق السيّد محمد رضا الجلالي (حفظه الله)، وغيره من الأساتذة المُحققين.
فإن أصبت في عملي، فذلك توفيق من الله تعالى ومنهم، وإن أخطأت، فذلك تقصير منِّي، وذلك سعيي وما على الإنسان إلّا أن يسعى.
على المرْءِ أنْ يَسْعى بِمقْدار جُهده وَلَيْسَ عليه أنْ يكونَ مُوفّقَا ِ
ثانياً: ومن أجل أن أعتبر بمَن سبقني من المُحققين، ولئلا أخطأ في عملي، رأيت أن أعرض عملي على بعض المُحققين؛ حتى أشركهم في رأيي؛ إذ قال الشاعر:
والرأيُ تصقلُه العقولُ تخالفتْ نظراً وقد يُصديه عقلٌ مفردُ
لأنّ الهدف من المتابعة المتنوعة ـ بعد القبول من الله سُبحانه وتعالى، ومن أهل البيت^ ـ هو أن يكون مقبولاً عند الجميع، وأن يكون ذا فائدة للقرّاء الكرام، فوقع الاختيار على أحد الأصدقاء ـ ياسين حسن السلامي ـ وهو ممّن لديه خبرة في هذا المجال؛ وذلك لتفرغه في أيّام تحقيق هذه الرسالة، فلم يألُ جهداً في متابعتي فيما كتبت، ومواكبتي فيما حقّقت، وقد أشار عليّ في إضافة بعض العناوين في المقدّمة، فوافقته الرأي على جملة منها، فكانت له المبادرة الذاتية في متابعة الكليات والجزئيات في كلّ ما يخص مراحل التحقيق، أدام الله توفيقه وكثر الربّ الحكيم أمثاله من الذين يؤثرون طريق الهدى بالإخلاص، والوفاء للدين العظيم، وتشييد صرحه المبارك.
ثالثاً: أتقدّم بالشكر الجزيل، والثناء العاطر لكلّ مَن مدَّ يدَ العون لي في هذا العمل، وكذلك مَن أعانني على تهيئة بعض المصادر، لا سيّما الأُستاذ المؤرخ والمُحقق السيّد سلمان هادي آل طعمة (حفظه الله)، في كربلاء.
رابعاً: رجائي من السادة العلماء الأفاضل، والأساتذة المُحققين الكرام، أن ينظروا في تحقيقي هذا بروح الأخ المُعين، فيذكروا لي ملاحظاتهم وآراءهم حتى تكون لي مناراً أهتدي بها، وأسير على ضوئها، وأستمد عزيمتي من شعاعها؛ إذ غير خفيٍّ على أصحاب هذا الفن المشاق التي يواجهها المُحقّق في عمله.
خامساً: أُنبّه على أمر مهم وهو: إنَّ إعادة تحقيق هذه الرسالة جاء تلبيةً لطلب (مؤسسة المرتضـى)؛ إذ هم الذين قاموا بإعداد هذه المخطوطة من مكاتبهم، أو من مؤسسات أُخرى، وحينما أخبرتهم بأنَّ هذه المخطوطة قد حُققت من قبلُ، قالوا: لا ضير في تحقيقها مرّة أُخرى.
وهنا أيضاً أُوجه شكري للمُحقق منتظر الحيدري؛ إذ لا شكّ أنِّي استفدت من تجربته في تحقيق هذه الرسالة.
سادساً: قد يقول قائل: إنَّ هذه المقدّمة، وما ذُكر فيها من تحقيق وتعليق، لا تتلاءم مع حجم الرسالة، وكأنَّ العمل التحقيقي أصبح كتاباً ثانياً!
والجواب:
أوّلاً: هناك الكثير من المخطوطات، وهي بقدر حجم هذه الرسالة، ولكن كُتبت لها مقدّمات بصفحات عدّة، وتكاد تكون أشبه بكتاب؛ وذلك لأهميّتها.
ثانياً: إنَّ كثرة الهوامش، وإن كانت تعادل كتاباً إلّا أنَّ منهج التحقيق يتطلبها.
ألا ترى دراسة الدكتور ثامر كاظم وتحقيقه لكتاب (الانتخاب القريب من التقريب)، للسيّد حسن الصدر+، فكان المتن في جميع صفحات الكتاب لا يتعدى السطرين، والباقي هو لذكر المصادر والتعليق.
ثالثاً: إنَّ ما ذُكر في مقدّمة التحقيق، أو التعليقات والمصادر في الهامش هي من صلب الموضوع، وليس فيها أيّ شيء خارج عنه؛ إذ ليس فيها رأي أو فكرة أُريد إقحامها وفرضها على القارئ.
رابعاً: إن كان في المقدّمة شيء من تحقيق بعض الأفكار والآراء التي ستأتي في الفصل القادم، فهي استجابة لِما طلبه المؤلف في خاتمة رسالته، وقد تقدّم ذكر طلبه من السيّد عبد الحسين الكليدار إكمال تحقيق هذا الموضوع.
خامساً: إنَّ ما ذكرناه في المقدّمة، وما ذُكر من تحقيق لبعض المسائل في الفصل القادم، لا يُراد منه أن يُعطي شأناً كبيراً لهذه الرسالة، بل العكس هو الصحيح، فهي وإن كانت صغيرةً في حجمها، ولكنَّها كبيرةً في محتواها، غزيرةً في مادتها، حكيمةً في منهجها، ولو لم نذكر في كتابنا هذا سوى نصّها لكانت: (كافية شافية، ومجزية مغنية، بل لوجدناها فاضلة على الكفاية، وغير مقصّـرة عن الغاية، وأحسن الكلام ما كان قليله يُغنيك عن كثيره). فهي التي رسمت الخطوط العامّة لتحقيق بعض المسائل، فنحن عيال عليها.
وأخيراً أحمده (جلّ ثناؤه) على ما وفّق في إكمال هذا العمل، وأرجو أن أكون قد أدخلت السرور وضاعفت الأجر والثواب على روح كاتب هذه الرسالة، السيّد حسن الصدر+ في هذا العمل المتواضع، وكذلك أرجو أن أكون قد قدّمت للمكتبة الإسلاميّة تحقيقاً مقبولاً، وللقرّاء الكرام عملاً نافعاً.
وأسأله (جلّ شأنه) العفو والرحمة عن زلل القلم وخطل الرأي، وإليه أرغب في أن يجعل هذا التحقيق خالصاً لوجهه الكريم، وذريعةً للقرب منه في دار النعيم، وكفارةً تضع ما كان في ميزان سيئاتي أو سيكون، وترفع ديوان حسناتي إلى مقام يشهده المُقربون، نافعاً لي ولغيري، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.
(وما توفيقي إِلَّا بِاللهِِ عليه توكَّلْت وإِليه أُنيب).
(وآخرُ دعوانا أَنِ الحمدُ لِلِه ربِّ العالمين).
السيّد حسين هاشم وتوت الحسيني[63]
نماذج من النسخة التي اعتمدنا عليها[64]
ترجمة مؤلف الرسالة السيّد حسن الصدر+
ترجم له العلماء وأصحاب التراجم والمُحققون والكُتّاب، ومن أشهر مَن ترجم له: آية الله السيّد عبد الحسين شرف الدين[65]، وآية الله الشيخ مرتضـى آل ياسين[66]، والسيّد محسن الأمين[67]، والسيّد علي النقي النقوي[68]، والسيّد المرعشـي النجفي[69]، والشيخ آغا بزرك الطهراني[70]، والشيخ محمد حرز الدين[71].
وهناك تراجم كثيرة ذكرها مُحقّقو كتبه+، منها: جامعة وأُخرى مختصـرة، وفي هذا الكتاب اعتمدنا الترجمة التي كتبها السيّد شرف الدين+؛ لأنَّها شافية وافية كافية، بل وفاضلة على الغاية.
وتصرّفنا في عرضها بشكل مختصر، وجاءت على شكل أسطر، وكلّ سطر يُعبّر عن فكرة معينة، ومَن أراد نصّها فهي مذكورة في مقدّمة (تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام)، وذلك بعد أن قدّمنا قبلها بكلمة موجزة عن السيّد+، واستشهدنا فيها بفقرات من هذه الترجمة، وختمت بذكر جملة من أقوال العلماء فيه.
العوامل التي أسهمت في إعداد شخصيّة السيّد حسن الصدر+
قيل إنَّ العوامل التي أسهمت في صياغة آية الله العظمى المرجع الأكبر السيّد حسن الصدر+ ـ وجعلته أحد أركان الدين والعلماء الربانيين، ومن علماء آل محمد وفقهائهم المقتفين آثارهم، والمهتدين بهداهم ـ عاملان: الوراثة والبيئة، كما قيل: «إنَّ من الحقائق التي لا ترديد فيها، إنَّ كلاً من الوراثة والبيئة يُسهمان في تنشئة الشخصيّة... حيث تآزرت الوراثة والبيئة على صياغة شخصيته [حسن الصدر] المعرفية...»[72].
ولعلّ الصحيح، أنَّ العوامل المؤثرة أربعة، وهي: (الوراثة، المُربِّي أو الموجّه، الجِد والاجتهاد، البيئة)، فهذه العوامل إن وجدت واتحدت بلغت بصاحبها من العليا كلّ مكان، وإن تخلّف عنها عامل قل طموحها وارتدّت عزائمها، ولم تصل إلى غايتها، وشاء الله تعالى أن تجتمع هذه العوامل وتتحد وتُسهم في صياغة شخصيّة السيّد حسن الصدر+.
وانطلق من أمرين:
1ـ النسب الموسوي الشريف المقدّس
فهو السيّد حسن صدر الدين، أبو محمد بن السيّد العلّامة السيّد هادي، بن السيّد محمد علي، بن السيّد الكبير السيّد الصالح، بن السيّد العلّامة السيّد محمد، بن إبراهيم شرف الدين، بن السيّد زين العابدين، بن السيّد نور الدين علي، بن علي بن الحسين بن محمد، بن الحسين بن علي، بن محمد بن أبي الحسن، بن محمد بن عبد الله، بن أحمد بن حمزة الأصغر، بن سعد الله بن حمزة الأكبر، بن محمد أبى السعادات، بن أبي الحرث محمد بن عبد الله، بن محمد بن أبي الحسن علي، بن أبي طاهر عبد الله بن أبي الحسن محمد المُحدّث، بن أبي الطيب طاهر بن الحسين القطيعي، بن موسى أبى سبْحة بن إبراهيم الأصغر المُلقّب بالمرتضـى، بن الإمام موسى الكاظم×.
2ـ الأُسرة الشريفة وتميّزها بالعلم والورع والجهاد
وتنقسم على صنفين:
الأوّل: وهي الأُسرة القريبة، فـ«قد أنشأه الله تعالى منشأً مُباركاً في حجر حكيم، كان من أبر الحجور المنجبة حجر أبيه المقدّس».
وتكريماً لهذا الرجل صاحب الكرامات الباهرة، والسيرة العطرة، الذي أنجب الصدر الكاظمي، نذكر له ترجمة للاطّلاع على سيرته لمِا فيها من عِظات مهمّة وعبر جَمّة؛ من أجل أخذ العِظة والعِبرة منها، وهي بقلم ولده السيّد حسن الصدر+، فقال يصف والده الأجل:
«السيّد الطاهر أبو الحسن الهادي ـ والد المؤلف ـ بن السيّد محمد علي، بن السيّد صالح بن السيّد محمد، بن السيّد إبراهيم شرف الدين بن السيّد زين العابدين، بن نور الدين الموسوي العاملي أصلاً، النجفي مولداً، الأصفهاني منشأً، الكاظمي مسكناً ومدفناً.
أحقُّ مَن نُظم في عقد هذا الشأن، ومَن يفتخر بذكره علماء هذا الزمان، عَلَم العِلم، ونتيجة الأعلام، البالغ في الفضل والفواضل أعلى مقام، سيّدنا وأُستاذنا الوالد الهادي، المقتدى بآثاره، المهتدي بأنواره، عمدة المُحققين قديماً وحديثاً، وملاذ المدققين تفسيراً وحديثاً، بحر العلم الذي ساغ لكلّ وارد، وكعبة الفضل التي ينطوي إليها كلّ قاصد، فذلكة الفضلاء، وبقية العرفاء، الرافع للعلوم أرفع راية، والجامع بين الرواية والدراية.
تولّد في النجف الأشرف سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف، وفي أيّام رضاعه زمّت ركائب والده العلّامة إلى نحو خراسان بالأهل والعيال، وبعد زيارة الإمام الرضا× مال إلى زيارة أخيه السيّد الصدر بأصفهان، فسأله الإقامة معه؛ حيث كانت أصفهان محط رحال الأفاضل في ذلك الزمان، فأقام غير بعيد، وفاجأه القضاء في سنة (1241هـ) كما شرحناه في ترجمته. فكفل الوالدَ السيّدُ عمُّه آية الله في العاملين السيّد صدر الدين، وربّاه في حجره، وكان أعزّ وُلْده، وكانت تزداد عنايته به ورعايته له يوماً بعد يوم؛ لما كان يرى من حسن استعداده للعلم ورغبته فيه، وهو مع ذلك يزيد في تشويقه، حتى أنَّه كتب له ألفية ابن مالك بالخط الفاخر على ورق الترمة وذهّبها له، وقرّر له في حفظ كلّ عشرة أبيات وإعرابها مع تفسيرها أشرفي[73].
وهكذا كانت عنايته به ورعايته له، حتى فرغ من كلّ العلوم العربية وسائر المقدّمات كـ(المنطق، والشرائع، وأُصول المعالم)، وهو ابن اثني عشرة سنة، وقد برع فيما قرأ حتى صار يحضـر عالي مجلس درس عمّه العلّامة في الفقه بأمره قبل بلوغه الحلم، وصار يستفيد من أنوار علومه ويتكلّم في بحثه، وهو مع ذلك يقرأ على أُستاذه المنطق والكلام، وكان هذا الأُستاذ هو الشيخ عبد الكريم المعروف الجامع للعلوم الغريبة والعلوم المتعارفة، فالتمسه على تعلّم علم الحروف والأعداد والرمل، وصار يرغّبه في ذلك لمِا يرى من علو فهمه وكمال استعداد، حتى أجابه إلى ذلك وتعلّم من تلك العلوم الغريبة ما يُبهر العقول، لكنَّه أخفى علمه بها إلى آخر عمره، ولم يكن لأحد ماسكة الكتمان التي كانت له، حتى أنِّي سألته ذات يوم أن يُعلّمني بعضها، فقال: يا ولدي، ما في تعلم هذه العلوم فريد فائدة، إلّا لمَن يقدر على كتمانها، أما تراني؟!
ثمَّ بعدما فرغ من درس عمّه هاجر إلى النجف، ولازم درس الشيخ حسن صاحب (أنوار الفقاهة)، ابن شيخ الطائفة كاشف الغطاء في الفقه، وقرأ علم الأُصول على الشيخ المرتضى&...
فاجتمع عليه من أهل العلم والأشراف ـ وفيهم الشيخ الأعظم الشيخ محمد حسن آل ياسين الكاظمي ـ فالتمسوا منه البقاء في بلد الكاظمين للتدريس، فأقام واشتغل بالتدريس وحضـر مجلس درس الشيخ المذكور، واستمر على ذلك مدّة، وفي نفسه الرجوع إلى النجف، فرجّحت له عمّته التزوج ببعض بنات الأجلّة، فاستخار الله (جلّ جلاله)، فساعدت الاستخارة، فتزوج بأُمّ أولاده المجلّلة والدتي المعظمة بنت الشيخ محمد بن شرف الحاج حسين بن مراد الهمداني من أكابر البيوتات، فكان ذلك سبباً لسكناه وقطع ما كان يتمناه.
واستدام على التدريس في سائر العلوم الدينية، كان يجلس من أوّل الصبح إلى الظهر يُدرّس في الفقه والأُصول، والكلام، والعلوم العربية، والمنطق، لا يُدّرس في ذلك كلّه سواه، وهو مع ذلك قائم بحوائج المحتاجين بأتمّ قيام، وعلى أحسن نظام... عبقت منه رائحة جدّه باب الحوائج، فصار كعبة القاصد، فكم من مريض عجز عنه الأطباء برئ بدعائه، أو يأكل من سؤره. كان لفمه وكلمه وقلمه تأثير عجيب في شفاء الأمراض وحصول الأغراض.
فكم من مبتلى بموت الأولاد أخذ من ثيابه لمولوده فعاش. وكان إذا كتب لمحروم الأولاد دعاءَ الولد رزقه الله ذلك.
وبالجملة حاز من الخصال محاسنها ومآثرها... لا يرجع منه السائل إلّا بحاجة مقضية، ولا فقير إلّا بصلة. وربما كان لا يجد النقد، فيُعطي السائل خاتمه، أو بعض ثيابه، أو بعض أواني داره، لا يستطيع ردّه بالكلية؛ لسخاء طبعه ورقة قلبه.
كان إذا مَرَّ في الصحن الشريف أو في الطريق ورأى من الغرباء لا يستطيع أن يرفع قدمه عنه، بل يقف عليه حتى يحسن إليه، ويصلح له ما يحتاج إليه ولو بالقرض والاستدانة. ولعمري لا يُستطاع ذكرُ مزاياه وما كان عليه من المكرمات والأوصاف، وقوة النفس وحسن التوكل، وقطع النظر عن الناس. وكان لا يقبل الحقوق من كلّ أحد، ويقول: إنِّي لا أقبض ممّن يُحدّث نفسه أنَّه أعطاني، أو جاء إليّ بحقٍّ فرضه الله عليه...
كان أشبه الناس بالسيّد جمال الدين علي بن طاووس بالورع عن الحكم والفتوى، وفي الزهد والمراقبة لمولاه، والمجاهدة ومحاسبة النفس.
وكان من أعلم الناس بعلم تهذيب الأخلاق، وكم له من الرياضات الشـرعية. وكان عالماً بالحديث والتفسير، عالي الأنظار في الأُصولين، مُصنفاً فيهما، كثر الاستحضار في الفقه، حسن المسلك فيه، خبيراً بالطب والرياضيات وعلم الأوائل، وله في علم الطب أُرجوزة ضمّنها نفائس مطالب الطب والعرفان، لم ينسج على منواله ناسج... وله في علم الكلام رسالة أملاها على بعض تلامذته من دون مراجعة كتاب، أوّلها بعد البسملة والحمدلة: هذه سطور تنتظم في بيان المعارف الخمس، أعني أُصول الدين...
ومن عجيب سيرته أنَّه كان قليل النوم. وإذا نام لا يمدّ رجليه، بل يجمعهما ويتكئ بزاوية حجرته، وكان لا يأكل في الليل والنهار إلّا مرّة واحدة، لا يزيد على نصف الرغيف...
مرض يوم السابع عشر من جمادى الأُولى بمرض البطن من غير حمى، وتُوفِّي بعد العصـر يوم الثاني والعشرين، سنة ست عشـرة وثلاثمائة بعد الألف. فقامت الصيحة في داره، وهاجت البلد بأسرها، وكثر الصراخ والبكاء من عموم الناس، نساءً ورجالاً... حتى إذا فرغوا من تجهيزه جاؤوا بنعشه إلى الصحن الشريف، وبعد الزيارة صلّيت عليه بوصية منه، ولما أُنزل في سرداب بقعته ليوضع في لحده، كان الحاج (ملا زمان المازندراني) واقفاً على باب السـرداب إلى جنبي، فقال لي: الله أكبر، وأخذته الرعدة. فقلت له: ما دهاك؟ فقال: هذا الحجة صاحب الزمان (عليه الصلاة والسلام) قد حضر إليه، وهو الآن في السرداب، فإنِّي أعرف رائحته المباركة.
قال: وما كنت أعرف عظم قدر هذا السيّد الجليل إلى هذه الدرجة.
وهذا الحاج (ملا زمان) من العلماء الربانيين المُرتاضين المجاهدين، الصائم القائم، الذي بلغ به الحال أنَّه يقتات في إفطاره أيّام رياضته بالمدينة الطيبة قدر لوزة واحدة...»[74].
وأمّا الثاني: فهي الأصل الذي يُرجع إليه، والمنبت الذي يُعتمد عليه، وتجسّدت في (آل الصدر)، فهو من هذه الأُسرة العلوية الشـريفة، وهي من أشهر الأُسر العلميّة المعروفة بالعلم والفضل، والرئاسة والجهاد، والتقوى والورع والصلاح، تأصلت شجرتها المقدّسة، وثبتت في جبل عامل من قرية (شد غيث)، وقرية (معركة)، وتفرّعت بعلمائها الأجلاء، وفقهائها الفضلاء، ومفكريها الأساطين، وبمجاهديها المقدّسين في الكاظمية والنجف بالعراق، وبأصفهان في إيران، وفي غيرها من بلدان العالم الإسلامي.
وهكذا شاءت السماء أن تسبغ عليه شرف الأُسرة، وتظلّه بكرم الآباء، وعظمة الأجداد، الذين سبقوا في المساعي المشكورة، والمآثر المحمودة في الوسط الذي نبغوا فيه، والواقع الذي انتموا إليه، والتربة التي نبتوا فيها مجداً متواصلاً، ومحتداً متأصلاً، وسؤدداً خالداً؛ إذ شهد لهم بذلك كلّ مَن عاصرهم من أهل حاضرتهم، وأكثر الحواضر الإسلاميّة.
ومن هنا ورث السيّد حسن الصدر في هذا العامل شرف الأُسرة والنسب الكريم، فحمل من الأُسرة شرفاً، ومن النسب ديناً، فكان من أُسرة (آل شرف الدين)[75].
العامل الثاني: المربي والموجّه
وهو إمّا أن يكون مباشراً كالأبوين، أو غير مباشر كالأُستاذ، ووُفّق السيّد حسن الصدر+ في الأمرين معاً.
فأمّا الأوّل: وهو المربي، فكان في هذا العامل كما ذكر المترجمون أنَّ أباه (أعلى الله مقامه) «بذل في تربيته جهده، واستفرغ في تأديبه وتهذيبه وُسْعَه، وبوأه من حكمته في تثقيفه، وشدّ أسره العلمي مبوّأ صدق، ينهج له سبل الحجى، ويعرج به إلى أوج الهدى»[76].
وأمّا تعليم والده إيّاه، فكان «يُهيمن عليه في كلّ دروسه، لا يألو جهداً في تنشيطه وتمرينه، ولا يدخر وسعاً في إرهاف عزمه[77]، وإغرائه في الإمعان بالبحث... وما أن بلغ الثامنة عشـر من عمره حتى خرج من سطوح الفقه والأُصول، أخذهما عن أبيه بكلّ ضبط وإتقان»[78].
وكذلك اختار له والده الأساتذة «حتى أتقن الصـرف والنحو، والمعاني والبيان والبديع، وتوغّل في علم المنطق درجة رفيعة»[79].
وارتحل ـ بأمر والده ـ أيضاً إلى النجف سنة (1290هـ).
ووالده هو الذي أشار عليه بالبقاء في الكاظمية بعد رجوعه من سامراء، بعد رحيل المرجع الشيرازي.
وقد أشار السيّد حسن+ إلى امتثاله لأمر والده، فقال: «وحللتُ بلد الكاظمين لا على عزم الإقامة، بل على قصد الرجوع إلى النجف الأشرف، فأمرني السيّد الوالد بالإقامة في بلد الكاظمين، فأقمت امتثالاً لأمره، وأنا فيها إلى هذا التاريخ، وهو سنة أربع وثلاثين بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة، لا اشتغال لي إلّا بالتأليف والتصنيف تاركاً لكلّ العناوين»[80].
وأمّا الثاني: فهو دور الأساتذة في تعليمه، وقد كان عصـره البهيج من أفضل العصور في كثرة العلماء والمجتهدين والمراجع، وقد تتلمذ على الكثير منهم، وقد أشار السيّد حسن الصدر+ إلى جملة منهم في الترجمة التي كتبها عن نفسه في تكملة أمل الآمل، فقال: «قرأت علوم العربية والمنطق والشـرائع، وبعض الروضة الدمشقية، والمعالم والقوانين، حتى جاءت سنة ثمان وثمانين، وهاجرت إلى النجف الأشرف، واشتغلت على العلماء، قرأت علمي الكلام والحكمة على الفاضل الآخوند المولى باقر الشكي، والشيخ محمد تقي الكلبايكاني، والفقه والأُصول على الميرزيَينِ حجتي الإسلام الميرزا محمد حسن الشيرازي، والمُحقق الميرزا حبيب الله الرشتي، وعلى الشيخ الفقيه محمد حسين الكاظمي، والفاضل المولى محمد الإيرواني، والمولى الفقيه الحاجي ملا علي بن الخليل الرازي، والسيّد المتبحر المهدي الشهير بالقزويني، والشيخ محمد اللاهجي، والآخوند ملا أحمد التبريزي، وغيرهم من علماء الفقه والأُصول على ترتيب يطول شرحه»[81].
إذا لم تكن لدى الإنسان قوة كامنة في نفسه، أو ملكة راسخة في شخصيته تدفعه نحو الجد والاجتهاد، فلا يرتفع به نسبه وإن كان شريفاً، ولا تسمو به أُسرته وإن كانت أصيلة المحتد.
وتلك الملكة الراسخة والقوة الكامنة وجدتا عند السيّد حسن الصدر+؛ إذ «كان من أوّل نشأته بعيد مرتقى الهمة نزّاعاً إلى الكمال، فحسر عن ساعد الجد، وقام في التحصيل على ساق. فبذّ[82] أقرانه، وجلّى وفاز دونهم بالقدح المعلى»[83]، وذلك حينما كان في مدينة الكاظمية.
وأمّا في النجف الأشرف، فارتحل «متأهباً متلبباً لبلوغ الكمال في علومه، حاسراً في ذلك عن ساعد الجدّ، قائماً فيه على ساق الاجتهاد... ولم يزل عاكفاً في النجف على الاشتغال، مجدّاً في تحصيل الكمال، جاداً في أخذ العلوم عن أفواه الرجال، قائماً في الاستفادة والإفادة على ساق، مدرساً ومؤلفاً، ومحاضراً، ومناظراً.
فشا ذكره في التحصيل على ألسنة الخاصّة والعامّة من أهل بلده، ورنّ صيته بالعقل والفضل، والهدى والرأي، وحسن السمت في تلك الناحية، فكان المثل الأعلى من شباب الفضيلة في حمد السيرة، وطيب السريرة، وجمال الخَلْق، وكمال الخُلُق»[84].
وكانت في ثلاث محطات:
الأُولى: مدينة الكاظمية، فكان فيها مجاور الإمامين الكاظمين÷، وفيها كانت نشأته الأُولى، وفيها اختار له والده أساتذة مَهَرة بررة من علماء الكاظمية.
الثانية: مدينة النجف الأشرف.
الثالثة: سامراء.
وهذه العوامل الأربعة: (الوراثة، المُربّي والموجّه، الِجد والاجتهاد، البيئة)، هي التي اجتمعت، فساهمت في صياغة آية الله العظمى المرجع الأكبر السيّد حسن الصدر+، وجعلته أحد أركان الدين، والعلماء الربانيين من علماء آل محمد|.
خلقه الله من طينة القُدس، وصاغه من معدن الشرف، وأنبته من أرومة الكرم. كان ربيط الجأش، صادق البأس، من حماة الحقائق، وممثلي الحفائظ. كان مُتجافياً عن مقاعد الكبر، نائياً عن مذاهب العُجب، سلس الطباع. كان جواداً سخياً، فيّاضاً أريحياً، ولا غرو فإنَّه كان من قوم فجّروا ينابيع الندى. كان حاد الذهن، يقظ الفؤاد، ذكي المشاعر، حديد الفهم، سريع الفطنة، له همّة بعيدة المرمى، ونفس رفيعة المصعد، تسمو به إلى معالي الأُمور
كانت مدارس سيارة تتفيأ وارف ظلاله في حِلّه وترحاله، فيها ما يبتغيه الإنسان، واضح الأُسلوب في كلامه، فخم العبارة، مُشرق الديباجة. كان مُنتجِعو مجالسه ينقلبون عنه بما التمسوه من ضوال الحكمة.
كان رحلةً في العلم كما كان قِبلةً في العمل، إماماً في الفقه، ومفزعاً في الدين. كان ثبتاً في السنن، وحجةً في الأخبار، ورأساً في أُصول الفقه وعلم الرجال، راسخ القدم في التفسير وسائر علوم الكتاب والسنّة، وما إلى ذلك. كان من ذوي البسطة في المنطق والحكمة، الراسخين في علم الكلام. كان بحراً في علم الأخلاق، لا يُسبر غوره، ولا يُنال دركه.
ثَبْتُ الغَدَرِ[85] في مناظراته؛ دفاعاً عن الدين الإسلامي، وانتصاراً للمذهب الإمامي. كان شديد العارضة[86]، غرب اللسان[87]، طويل النفس، بعيد غور الحجة[88]، يقطع المُبطل بالحقّ فيرميه بسُكاته، ويدمغه بأقحاف رأسه[89]، فإذا هو زاهق، يقتضب جوامع الكلم، ونوابغ الحكم، فتكون فصل الخطاب، ومفصل الصواب.
أمّا الأدب العربي، فقد كان «جُذيْلَه المُحكّك، وعُذيْقَهُ المُرجّب»[90] صحيح النقد فيه، وأنَّ الذي كانت تطمح إليه نفسه من نظم القريظ، لم يكن ميسوراً لانصرافه عنه.
إنَّ همته رفيعة المناط، قصية المرمى، تأبى عليه إلّا السبق في كلّ مضمار.
ولع منذُ حداثته إلى مُنتهى أيّامه في جميع الكتب، وعنى بذلك كلّ العناية. كان يؤثر تحصيلها على بُلغته ونفقة يومه، وربما باع في سبيلها الضروري. تضمّنت مكتبته من نوادر الأسفار المخطوطة ما لا يوجد في أكثر المكاتب، ذكرها المتتبع البحّاثة جرجي زيدان في طليعة مكاتب العراق. عنى السيّد بهذه المكتبة فألف لها فهرساً أسماه (الإبانة عن كتب الخزانة).
على صنفين: مَن يروي عنهم بطريق السماع والقراءة فقط دون الإجازة، ومنهم مَن يروي عنهم بطريق الإجازة العامّة.
وقد ذكر تراجمهم على طرز مبسوط في إجازاته المطولات.
كان (أعلى الله مقامه) ممّن لهم الميزة الظاهرة والغرة الواضحة في التأليف. كتب في مواضيع مختلفة من علوم شتى، وما منها إلّا غزير المادة.
1ـ كتاب الدرر الموسويّة في شرح العقائد الجعفريّة.
2ـ سبيل الصالحين في السلوك وطريق العبودية. وقد ذكر لها سبع طرق.
3ـ إحياء النفوس بآداب ابن طاووس.
4ـ كتاب سبيل الرشاد في شرح نجاة العباد. على سبيل الاستدلال.
5ـ كتاب تبيين مدارك السداد للمتن والحواشي من نجاة العباد.
6ـ تحصيل الفروع الدينية في فقه الإماميّة. كتاب ينفع المُحتاط والمُقلد.
7ـ المسائل المهمّة. رسالة شريفة في العبادات لعمل المقلدين.
8 ـ المسائل النفيسة. رسالة أفردها لمشكلات المسائل الفقهيّة والفروع الغريبة.
9ـ حواشيه على العروة، والغاية القصوى، ونجاة العباد، والتبصرة، وعلى الفصول.
10ـ الغالية لأهل الأنظار العالية. رسالة بالعربية والفارسية في تحريم حلق اللحى.
11ـ تبيين الرشاد في لبس السواد على الأئمّة الأمجاد. رسالة بالفارسية.
12ـ نهج السداد في حكم أراضي السواد.
13ـ الدر النظيم في مسألة التتميم. رسالة في تتميم الكر بماء مُتنجس.
14ـ لزوم قضاء ما فات من الصوم في سنة الفوات.
15ـ تبيين الإباحة. رسالة في جواز الصلاة بأجزاء الحيوان المشكوك في إباحة أكله.
16ـ إبانة الصدور. رسالة في موقوفة ابن أُذينة في مسألة إرث ذات الولد من الرباع.
17ـ كشف الالتباس عن قاعدة الناس. أعني: (الناس مسلّطون على أموالهم).
18ـ الغرر في نفي الضرار والضرر. رسالة جليلة فيها تحقيقات.
19ـ أحكام الشكوك الغير منصوصة. رسالة استدلالية.
20ـ رسالة في حكم الظنّ بالأفعال والشك فيها.
21ـ الرسائل في أجوبة المسائل. رسالة تشتمل على فتاواه التي أجاب بها مقلديه.
22ـ سبيل النجاة في المعاملات.
23ـ تعليقة على رسالة التقية لشيخنا الأنصاري.
24ـ تعليقة على مباحث المياه من كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري+.
25ـ الرسالة في حكم ماء الغسالة.
26ـ رسالة في تطهير المياه.
27ـ رسالة في مسألة تقوي العالي بالسافل.
28ـ تعليقة مبسوطة على ما كتبه الشيخ الأنصاري في صلاة الجماعة.
29ـ رسالة في شروط الشهادة على الرضاع.
30ـ رسالة في بعض مسائل الوقف.
31ـ رسالة في حكم ماء الاستنجاء.
32ـ رسالة في الماء المضاف.
33ـ رسالة وجيزة في رواية الإخفات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين.
34ـ مِنى الناسك في المناسك. رسالة حافلة أفردها لمناسك الحج والعمرة.
35ـ شرح وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة. كتاب لم يُصنّف مثله.
36ـ كتاب تحية أهل القبور بالمأثور. مُرتّب على عشرة أبواب وخاتمة.
37ـ كتاب مجالس المؤمنين في وفيات الأئمّة المعصومين.
38ـ مفتاح السعادة وملاذ العبادة. يشتمل على المهم من أعمال اليوم والليلة و...
39ـ كتاب تعريف الجنان في حقوق الإخوان. سفر جليل فيه مطالب ونصائح.
40ـ رسالة في المناقب. مُستخرجة من الجامع الصغير للسيوطي.
41ـ كتاب النصوص المأثورة. على الحجة المهدي# من طريق الجمهور.
42ـ كتاب صحيح الخبر في الجمع بين الصلاتين في الحضر.
43ـ كتاب الحقائق في فضائل أهل البيت^ من طريق الجمهور.
44ـ كتاب أحاديث الرجعة.
45ـ هداية النجدين وتفصيل الجندين. رسالة في شرح حديث جنود العقل والجهل.
46ـ كتاب نهاية الدراية. شرح فيه وجيزة الشيخ البهائي.
47ـ كتاب بُغية الوعاة في طرق طبقات مشايخ الإجازات.
48ـ كتاب مختلف الرجال. دوّن فيه هذا العلم بذكر حدّه وموضوعه وغايته و...
49ـ عيون الرجال. كتاب ذكر فيه الرجال الذين نصّ على ثقتهم أكثر من واحد.
50ـ نكت الرجال من تعليقة عمّه السيّد صدر الدين على رجال الشيخ أبى علي.
51ـ انتخاب القريب من التقريب. أفرده لرجال نصّ على تشيعهم ابن حجر.
52ـ رسالة في ترجمة المحسن الحسيني الأعرجي وسمّاها (ذكرى المحسنين).
53ـ بهجة النادي في أحوال (والده) أبى الحسن الهادي.
54ـ كتاب تكملة أمل الآمل. وهو في بابه عديم النضير.
55ـ البيان البديع في أنَّ محمد بن إسماعيل في أسانيد الكافي إنَّما هو بزيع.
56ـ التعليقة على مُنتهى المقال.
57ـ تأسيس الشيعة الكرام لعلوم الإسلام. كتاب لا نظير له في بابه.
58ـ الشيعة وفنون الإسلام. كتاب ما أجلّه قدراً، اختصره من كتابه السابق.
59ـ فصل القضا في الكتاب المشهور بفقه الرضا. كشف فيه حال هذا الكتاب.
60ـ رسالة في أنَّ مؤلف مصباح الشريعة إنَّما هو سليمان الصهرشتي.
61ـ الإبانة عن كتب الخزانة. أي: خزانة كتبه، استقصى فيها ما لديه من الكتب.
له فيه: (إحياء النفوس)، و(كتاب سبيل الصالحين) المتقدّم ذكرهما.
62ـ ورسالة وجيزة في المراقبة.
63ـ ورسالة أُخرى في السلوك.
64ـ قاطعة اللجاج في تزييف أهل الاعوجاج. وهم الأخبارية منكرو الاجتهاد.
65ـ البراهين الجلية في ضلال ابن تيمية. أقام الأدلّة فيه على ضلاله.
66ـ الفرقة الناجية. رسالة تُثبت أنَّ تلك الفرقة إنَّما هي الإماميّة.
67ـ عمر وقوله: هجر.
68ـ رسالة شريفة في الردّ على الوهابيين. إذ أفتوا على حرمة البناء على الضرائح.
69ـ اللوامع. كتاب في أُصول الفقه يتضمّن نتائج أفكار الأنصاري والشيرازي.
70ـ تعليقة على رسائل الشيخ مرتضى الأنصاري.
71ـ اللباب في شرح رسالة الاستصحاب. مجلد ضخم.
72ـ رسالة في تعارض الاستصحابين.
73ـ حدائق الأُصول. خرّج منه مسائل مُتفرّقة من مشكلات أُصول الفقه.
74ـ التعادل والتعارض والتراجيح. رسالة غير ما علّقه على رسائل الشيخ.
75ـ خلاصة النحو. كتاب لخّص فيه هذا العلم على ترتيب ألفية ابن مالك.
76ـ نزهة أهل الحرمين في عمارة المشهدين (مشهد أمير المؤمنين ومشهد الحسين).
77ـ وفيات الأعلام من الشيعة الكرام. كتاب يتبيّن موضوعه من اسمه.
78ـ محاربو الله ورسوله يوم الطفوف، في عدد المُخرَجين إلى حرب سيّد الشهداء.
79ـ المطاعن. كتاب يتضمّن طعن بعض علماء الجمهور على بعض.
80 ـ النسيء. رسالة تُبيّن فيها كُنه ما كان عليه أهل الجاهليّة من النسيء.
81 ـ كشف الظنون عن خيانة المأمون. رسالة تُثبت خيانته الفادحة بسمِّ الرضا×.
82 ـ محاسن الرسائل في معرفة الأوائل. في خمسة عشر باباً.
1ـ السيّد هادي الصدر والده المعظم.
2ـ الميرزا محمد حسن الشيرازي.
3ـ الشيخ محمد حسين الكاظمي.
4ـ الملا علي بن الميرزا خليل الطهراني.
5ـ الملا محمد الإيرواني.
6ـ الشيخ محمد تقي الكلبايكاني.
7ـ الميرزا باقر الشكي.
8ـ الميرزا حبيب الله الرشتي.
9ـ الشيخ أحمد العطار.
10ـ السيّد مهدي القزويني.
11ـ الشيخ باقر بن الشيخ محمد حسن آل ياسين.
12ـ السيّد باقر بن السيّد حيدر.
13ـ الميرزا باقر زين العابدين السلماسي.
14ـ الشيخ محمد بن الحاج كاظم الكاظمي.
1ـ السيّد أبو الحسن الأصفهاني.
2ـ الشيخ محمد حسين الأصفهاني (صاحب الحاشية على الكافية).
3ـ السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي.
4ـ الشيخ محمد رضا آل ياسين الكاظمي.
5ـ السيّد رضا الموسوي الهندي (صاحب الكوثرية).
6ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين(صاحب المراجعات).
7ـ الشيخ هادي آل كاشف الغطاء.
8 ـ السيّد هبة الدين الشهرستاني.
9ـ الشيخ آغا بزرك الطهراني.
10ـ الشيخ آغا رضا الأصفهاني (صاحب نقد فلسفة داروين).
11ـ السيّد أبو الحسن النقوي اللكهنوي.
12ـ السيّد علي نقي النقوي.
13ـ السيّد محمد مرتضـى الجنفوري الهندي.
14ـ السيّد شبير حسن الفيض آبادي.
15ـ الميرزا محمد علي الأوردبادي.
16ـ السيّد صدر الدين الصدر.
17ـ الشيخ محمد كاظم الشيرازي.
18ـ السيّد الميرزا هادي الخراساني.
19ـ الحاج الشيخ علي القمي.
قال السيّد النقوي (أدام الله إفاداته): توفِّي& في عاصمة البلاد العراقية بغداد ـ حيث كان مقامه منذُ أيّام فيها؛ لأجل المعالجة ـ في منتصف ربيع الأوّل سنة (1354هـ)، فكان لوفاته أثر كبير، ووقع خطير في النفوس جميعاً، وقد شيّع جنازته إلى الكاظمية مسقط رأسه ومدفنه زهاءُ مائة ألف من الناس من جميع الطبقات.
وقد أوفد جلالة الملك غازي مَن ينوب عنه في تشييعه، ودُفن في جوار جدّه الإمام موسى بن جعفر×، وقد طار صدى وفاته إلى سائر المناطق العراقية، وعلى الأخصّ النجف الأشرف، فأُقيمت الفواتح وأعظمها الفاتحة التي أقامها في النجف ثلاثة أيّام رئيسُ الشيعة آية الله السيّد أبو الحسن الأصفهاني (دام ظلّه).
وقال آغا بزرك الطهراني: توفِّي& ببغداد ليلة الخميس (11/ع1/1354هـ)، وحُمل إلى الكاظمية بتشييع عظيم، حضـره العلماء والعظماء، وممثل الملك، والوزراء والنواب وسائر الطبقات، ودُفن مع والده المقدّس في حجرة من حجر الصحن الشـريف، وأحدثت وفاته دوياً في العالم الإسلامي، ولا غرو فقد كانت الخسارة بفقده عظيمة، والخطب جسيماً، إلّا أنَّه ترك لنا ثروة كبيرة، وبضاعة ثمينة، وهي آثاره الجليلة، وتصانيفه الممتعة.
وجاء في ترجمته+: أرّخ عام وفاته جماعة من الأدباء نظماً باللغتين الفارسيّة والعربيّة، تواريخ كثيرة لعلّها ناهزت العشـرين، ومنها: نظم الشيخ الفقيه العلّامة الحجة الشيخ مرتضى آل ياسين (طيب الله أنفاسه):
|
غبتَ فلا قلبٌ خبتْ نارُه |
|
كلّا ولا عينٌ عراها الوسنْ |
|
فليتَ إذ فارقتَ هذا الحمى |
|
قدْ فارقتْ روحي هذا البدنْ |
|
سكنتَ دارَ الخُلد فاهنأْ بها |
|
فهي لعمُر الله نعمَ السكنْ |
|
إنْ غبتَ عن عيني فقدْ أصبحتْ |
|
ترمقُ عيناك عيونُ الزمنْ |
|
ومنُذُ أنْ غِبْتَ نعاكَ الهُدى |
|
أرّخْ لقدْ غابَ الزّكيُّ الحسنْ |
أولاده
وهو رئيس مجلس الوزراء في العهد الملكي، ومن الشخصيّات البارزة في العلم والسياسة. وقد ذكره الشيخ محمد مرعي الأنطاكي في الحديث عن رحلته إلى زيارة المراقد المشرّفة، فقال: «ففي بغداد حللت ضيفاً على حضـرة صاحب السماحة والفخامة، بطل العراق المعظّم، والسياسي المحنّك، العلّامة الحجة السيّد محمد الصدر رئيس الوزراء المعظم».
وقال عنه في الهامش: «هو العلّامة الكبير، والسياسي الشهير، صاحب المواقف البطوليّة المشهورة، والخدمات الإسلاميّة المشكورة، وهو أوّل عالم ديني تسنّم كرسي رئاسة الوزارة في العراق، وذلك في عام (1367ه)، وقد أرّخ بعض الشعراء تاريخ جلوسه على كرسي الرئاسة، بقوله:
|
ربح العراق وزارة |
|
ميمونة فله البشارة |
|
ورئيسها الصدر الزعيم |
|
(محمد) زان الصدارة |
|
ولئن شدى التاريخ قال |
|
ترأس الصــــدر الـــــوزارة»[92] |
السيّد علي الصدر
وهو الذي تربّع بعد فقد والده على المنصّة الدينيّة، فكان يؤمُّ المصلّين في محلّ والده،
فشخُصت إليه الأبصار، وتوجّهت نحوه النفوس، تهتدي بهديه وتنهل من علمه.
وقد كان له اهتمام بمؤلفات والده بعد رحيله في نسخها وطباعتها، ومنها: طباعة كتاب (التكملة)، وذلك بتشجيع واهتمام من صاحب الذريعة[93]. وقد ذكر عنه ـ كما سيأتي ـ أنَّه كتب مجموعة من رسائل والده السيّد حسن الصدر+، وهو والد السيّد مهدي الصدر، مؤلف كتاب (أخلاق أهل البيت^)، والسيّد محمد هادي القاضي العالم الأديب.
ثناء العلماء والمؤرخين والأدباء عليه
السيّد الصدر أُعجوبة الزمان، ومفخرة الأماني الإنسانيّة الغالية
السيّد حسن الصدر+ مصداق لأُعجوبة الزمان، وهو أحد الجواهر الفريدة التي مرّت عبر التاريخ، ومفخرة الأماني الإنسانيّة الغالية، وهو مفخرة الفقهاء والمُتكلّمين، والأُصوليين والرجاليين، لا يمكن أن تُحيط به الأقلام؛ لأنَّها تجد نفسها أمام عظمته الموسوعيّة الكبرى، فهو بحر محيط ليس له ساحل، وعنده تُكمّ الأفواه؛ إذ كيف لظامئ أن يتحدّث عن ريّ رويّ، ومرتوى ذلك هو صدر الحوزة العلميّة، وقلب المرجعيّة الدينيّة، أحد أركان الهدى، وأبواب التقى، ومظاهر الدين، ومعاجم المعرفة، ومفاخر الأُمّة، وأصحاب الشأن العظيم.
والسيّد حسن الصدر+ مصداقٌ لعظمة الخالق المبدع، الذي جلّى للمجتمع العلمي عَلَماً مثله، فريد في كلّ ما صدر عنه، وكأنَّه ينظم على لسانه الدر المنظوم، واللؤلؤ المكنون، والرحيق المختوم، في كلّ ما يكتب وما يقول، ومَن لم يصدق فليطلع على ما ذكره العلماء الأجلاء في شخصيته، وسيرته الحافلة بالنشاط الفعّال والحي الذي يُعبّر عن شخص قل نظيره.
وحقيق بنا أن نفتخر ونتعجب أمام هذه القدرة الإلهيّة الفائقة، هكذا يخلق الله عباده المُخلصين، أصحاب الذكاء الخارق، الذين أذهلوا السامعين والقارئين عنه حتى يقول القائل قول الله تعالى فيه: (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) [94]. وعندما نقول كما في النصّ القرآني المجيد: (قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا) [95]، فإذا كانت هذه الآية في كلمات الله، فإنَّ سماحته إحدى هذه الكلمات الفاخرة، التي تبلغ هذه المراتب العالية من العلم الجمّ، الذي لا نفاد له، فكيف بخالقه العظيم؟!
فيا للعجب! إنَّه أُعجوبة الزمان ومفخرة الأماني الإنسانيّة الغالية التي تُذهل لفضاء علمه، وسحر بيانه، وجود عبقريته. ومن هنا وجب علينا أن نتذكر آلاء الله ورحمته بعباده، أن وهب لهم هذه الملكات التي قدّرها في فرد واحد كشخصيته+، وليسجدوا عباد الله شكراً على هذه النعم، التي وعدنا عليها ربُّ العزّة والعظمة. والسيّد حسن الصدر+ مصداق لأُمّة تجسّدت في رجل، والأُمم إنَّما تعتز بعلمائها وتحتفل بهم وتكرّمهم؛ لأنَّهم واصلوا تشييد الحضارة الإسلاميّة وتقعيدها، ولأنَّهم قدّموا للأُمّة الحياة الكريمة.
ولذا يجب أن تكون هناك جملة من المواقف والأعمال، والتصـرفات والكلمات اتجاه السيّد حسن الصدر+؛ من أجل تكريمه وتخليده عبر العصور؛ لأنَّه العظيم الذي قدّم لأُمته كلّ ما يستطيع أن يبذله لأجلها، فحقّ عليها شكره، وأن تسعى في كلّ عصر ومصر، لأن تخلّدَ ذكره.
ومن هنا أحمد الله تعالى على أن وفقني لأن أكون من المحظوظين في إحياء ذكره، عبر تحقيق إحدى رسائله، هذا أوّلاً.
وثانياً: رأيت أن أذكر في خاتمة هذه الترجمة أحد تلك المسائل المُخلّدة، وتمثّلت في ذكر كلمات الثناء والتقدير التي كتبها عن شخصيته المباركة علماءُ أفاضل، وأدباء أجلاء، وأُقدّم اعتذاري لقصور الباع في التعريف به؛ لأنَّ مُترجمه يقف عند بحر متلاطم الأمواج، تقصر الهمم عن بلوغ مقاصده، كيف لا وهو مَن لا يُحيط بعلمه إلّا مَن يعلمه الله تعالى أهلاً لذلك.
قال السيّد عبد الحسين شرف الدين في ترجمته: «خلقه الله من طينة القُدس، وصاغه من معدن الشرف، وأنبته من أرومة الكرم، وجمع فيه خلال النجابة، فكان المجد ينطق من محاسن خِلاله، والمروءة تشتمل في منطقه وأفعاله. لم أرَ أكرم منه خُلقاً، ولا أنبل منه فطرةً، وكان ربيط الجأش[96]، صادق البأس»[97].
وقال السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة: «وهو من عائلة شرف وعلم وفضل... كان عالماً، فاضلاً، بهيّ الطلعة، متبحراً، منقّباً، أُصولياً، فقيهاً، مُتكلماً، مواظباً على الدرس والتأليف والتصنيف طول حياته»[98].
وقال محمد حرز الدين في معارف الرجال: «الثقة العدل الأمين، ذو الفضل الواسع، والعلم الغزير، صاحب التآليف والتصانيف، له الباع الطويل في علم الرجال، وآثار العلماء، وأهل الفضل، المعاصر الجليل، لنا صحبة كاملة معه...»[99].
وقال تلميذه وابن شقيقته الشيخ مرتضى آل ياسين: «لقد كنت أسمع عن السيّد المؤلف زمان كان شاباً قوي العضلات، أنَّه كان لا يكاد ينام الليل في سبيل تحصيله، كما أنَّه لا يعرف القيلولة في النهار، ولكنّي بدل أن أسمع ذلك عنه في زمن شبيبته، فقد شاهدت ذلك منه بأُم عيني في زمن شيخوخته، وأنَّ مكتبته التي يأوي إليها الليل والنهار ويجلس هناك بيمناه القلم وبيسراه القرطاس، لهي الشاهد الفذّ بأنَّ عيني صاحبها المفتوحين في الليل لا يطبق أجفانها الكرى في النهار، وإن جاءها الكرى، فإنَّما يجيؤها حثاثاً لا يكاد يلبث حتى يزول»[100].
وقال أمين الريحاني يصف شخصيته وزهده وإنفاقه: «قد زرت السيّد حسن صدر الدين في بيته بالكاظمية، فألفيته رجلاً عظيم الخلق والخُلق، ذا جبين رفيع وضّاح، ولحية كثة بيضاء، له عينان هما جمرتان فوق خدين هما وردتان، عريض الكتف، طويل القامة، مفتول الساعدين، وهو يعتم بعمامة سوداء كبيرة، ويلبس قميصاً، مكشوف الصدر، رحب الأردان، فيظهر ساعده عند الإشارة في الحديث.
ما رأيت في رحلتي العربية كلّها مَن أعاد إليّ ذكر الأنبياء، كما يُصوّرهم التأريخ ويصفهم الشعراء والفنانون مثل هذا الرجل الشيعي الكبير، وما أجمل ما يعيش فيه من البساطة والتقشف، ظننتني وأنا داخل إلى بيته أعبر بيت أحد خدامه إليه، وعندما رأيته جالساً على حصير في غرفة ليس فيها غير الحصير وبضعة مساند.
وقد كنت علمت أن لفتواه أكثر من مليوني سميع مطيع، وأنَّ ملايين من الرُّبيّات تجيؤه من المؤمنين في الهند وإيران؛ ليصرفها في سبيل البر والإحسان، وأنَّه مع ذلك يعيش زاهداً متقشفاً، ولا يبذل مما يجيؤه روبيّة واحدة في غير سبيلها، أكبرت الرجل أيّما إكبار، ووددت لو أن في رؤسائنا الدينيين الذين يرفلون بالأرجوان، ولا يندر في أعمالهم غير الإحسان بضعة رجال أمثاله»[101].
وقال السيّد النقوي: «كان& في رواية الحديث، أعظم شيخ تدور عليه طبقات الأحاديث العالية في هذا العصر، ومَن يروي عنه من أعلام هذا العصر كثير، وفيهم جملة من حجج الطائفة وعلمائها وفضلائها المبرزين، فمنهم: الآية العظمى السيّد أبو الحسن الأصفهاني النجفي (دام ظله)، والشيخ هادي آل كاشف الغطاء، والشيخ المحسن المعروف بـ(آغا بزرك الطهراني)، وأروي عنه بإجازة كتبها لي في 11 شوال سنة (1346ه)، وهو أوّل شيخ للحديث استجزت منه، فأجاز لي بإجازة عامّة، شاملة لكلّ ما بأيدينا من كتب الحديث والتفسير وسائر العلوم»[102].
وقال آغا بزرك الطهراني: «اشتغل بالتصنيف والتأليف في جميع العلوم الإسلاميّة من الفقه والأُصول، والدراية والحديث، والنسب، والتاريخ والسير والتراجم، والأخلاق، والحكمة، والجدل والمناظرة، والمناقب وغيرها من فنون العلم، وكان طويل الباع، واسع الاطّلاع، غزير المادة في تمام العلوم... وهو من النادرين الذين جمعوا في التأليف بين الإكثار والتحقيق، فتصانيفه على كثرتها وضخامة مجلداتها، وتعدد أجزائها، هي الغاية في بابها، فقد كان ممعناً في تتبع آثار المتقدّمين والمتأخرين من الشيعة والسنة، موغلاً في البحث عن دخائلهم، وممحصاً لحقائقهم، ومستجلياً ما في آثارهم من الغوامض، ومستخرجاً المُخبّآت بتحقيقات أنيقة رشيقة، فقد تجاوزت تصانيفه السبعين، وكلّها نافعة جليلة، وهامّة مُفيدة.
وكان بالإضافة إلى ذلك على جانب عظيم من الورع والصلاح، والتقوى والعبادة والزهد، والمراقبة والمجاهدة، وبالجملة فقد كان المُترجَم من الأبطال الأبدال، والعباد الأوتاد، والنوابغ الذين لا يجود بهم الزمن إلّا في فترات قليلة. وقد عاشرته مدّةً طويلةً، وسنيناً كثيرةً، فشاهدته مراقباً لله، سالكاً إليه، مجاهداً للنفس، مُسلَّطاً عليها، وكانت بيننا مودّة كاملة، وصحبة متواصلة، دامت قرب ثلاثين سنة... وكان& من شيوخ الإجازات في عصـره، ويروي بالإجازة عنه جمع كثير من الأعلام والأجلاء، وبما أنَّه كان متبحّراً في هذا العلم، وسابراً لغوره، كانت إجازاته طويلة في الغالب، ومحتوية على فوائد رجالية»[103].
وقال السيّد المرعشي النجفي+: «شيخ مشايخ الرواية، وقطب رحاها، مركز الإجازة ومحور أُكراها[104]، فخر الفقهاء والمُحدّثين، أُنموذج السلف الصالحين، بقية الماضين من آل طه وياسين، آية الله في العالمين. خرّيت علوم الحديث، شرف العترة الطاهرة، مولانا وأُستاذنا ومَن عليه اعتمادنا... كان من أعاجيب الدهر، وأغاليط الزمان في الإحاطة بأحاديث الفريقين، وأحوال الرواة، ومسائل الجرح والتعديل، قوي الحافظة، نقي القريحة، جيد الفكرة، كيّس الفطنة، حديد الذهن، حلو التقرير، سلس التحرير، جمّ المحاسن، نابغة العصر، استفدنا في الرجال والحديث والفقه والدراية من حلقة درسه طيلة إقامتنا بمشهد الكاظمين‘»[105].
من مقال في إحدى الصحف اللبنانية: «إنَّ الفقيد العظيم عبقري العباقرة، وأكبر قادة الفكر في القرن العشـرين، فإنَّ العلماء، وإنَّ طبقات المنوّرين الأفذاذ، كانوا ولا يزالون ينحون نحو الاختصاص بضـرب من ضروب الفنون والآداب والمعارف... ولكن همّة سيّدنا الفقيد العظيم لم تقف عند حدّ، ولم يكن لها غاية أو أمد، قد شاء أن يجعل صدره موسوعة علميّة محيطة، غوّاصة على دقائق المسائل من شتى العلوم، فسعى لذلك، فإذا هو قيم بيده لكلّ علم مفتاح مطواع يديره متى شاء، فيُخرِج من كنوز العقل والنقل كلّ لؤلؤة وهّاجة، لا يقتحم نورها البصر. وإنَّك لمأخوذ بالدهش إذا وقفت أمام مؤلفاته التي تجاوزت المائة وبعضٌ منها فيه مجلدات كثيرة»[106].
الفصل الثاني : تحقيق بعض مواضيع الرسالة، ومنهج المؤلف فيها
تعريف بموضوع الرسالة، وتحقيقها، ومنهج المؤلف فيها
أجاب المؤلف عن سؤال السائل، وفي بعض جوانب الإجابة ذكر المؤلف إشارات ولم يفصّل فيها؛ لشغله الشاغل عن إتمام الجواب، وأمرَ في خاتمة الرسالة أن يُكمل السيّد السائل تحقيق الموضوع إن أراد التفصيل.
وقد حاولنا أن نطّلع على مؤلفات السيّد عبد الحسين الكليدار، لعلّنا نوفّق للاطلاع على تحقيقه، إن كان له تحقّق في هذا المجال، فرأينا أن نرجع إلى كتبه التي تتحدّث عن كربلاء؛ باعتبارها أقرب إلى ما نحن بصدد تحقيقه.
وقد حصلنا عن طريق السيّد الباحث والمؤرخ السيّد سلمان آل طعمة على مؤلَّف للسيّد عبد الحسين بعنوان: (تاريخ كربلاء المعلى)، طُبع سنة (1349هـ)، وكان صغير الحجم، ولم نجد فيه بُغيتنا، وذُكر في ترجمته أنَّ له كتاب (بُغية النبلاء في تاريخ كربلاء)[107]، ولا ندري هل أنَّه أشار فيه إلى إجابة السيّد حسن الصدر+ عن سؤاله هذا، أو حقق بعض مواضيعها أم لا.
ونحن في هذا الفصل سنتحدّث عن بعض المواضيع التي وردت في هذه الرسالة، مع ذكر مسائل يتطلبها التحقيق، وهي مما أشار إليها السيّد حسن الصدر+، أو تلك التي لم يُفصّل الحديث عنها.
وهو واضح من تعريف موضوعها، فهي تتحدّث عن تحديد عدد الذين أُخرجوا لحرب الإمام الحسين×.
والرسالة كما تقدّم، هي جواب عن سؤال وجّهه إلى المؤلف، خازنُ الروضة الحسينيّة عن معرفة الرقم الحقيقي لهذا العدد، وأنَّه لم يعثرْ على مَن زادَ على العدد الذي ذكره أبو جعفرٍ الطبري في تاريخه الكبير ـ وهو (أربعة آلاف) ـ من المؤرخين أو المحدّثين من علماء السنّة.
وقد صنّف الكثير من علماء الشيعة الكرام المُصنّفات والموسوعات عن أصحاب الإمام الحسين×، فأحصوا أعدادهم، وذكروا أخبارهم وأحاديثهم، وأرّخوا لحياتهم ومواقفهم وتصـرفاتهم، سواء أكانت قبل واقعة الطفّ، أم ما صدر عنهم فيها.
بينما في الجهة الثانية ـ أعني: أتباع الخلفاء ومَن سار على النهج الأُموي ـ لم نجد فيها مَن تعرّض لذكر أصحاب يزيد في واقعة الطفّ، إلّا في حدود ما ورد ذكرهم في كتب التراجم والتاريخ، فلم تكن هناك مؤلفات أو موسوعات اختصت بهم؛ وذلك لأسباب كثيرة ومن أبرزها:
أوّلاً: إنَّ الكثير من علمائهم يعتبرون ما صدر عنهم في واقعة الطفّ عملاً إرهابياً، استهدف القضاء على الدين الإسلامي الأصيل، حتى ذهب قول الشاعر كثير عزّة عندهم مثلاً، يستشهدون به على تضحية بني أُميّة بالدين من أجل دنياهم، حين قال: «ضحّى آل أبي سفيان بالدين يوم الطفّ، وضحّى آل مروان بالكرم يوم العقر»[108].
وثانياً: سيكون في هذا الأمر إحياءٌ لذكرهم، وفي ذكرهم إحياءٌ لواقعة الطفّ، وهذا خلاف ما يعتقدون به من وجوب إخفاء هذه الواقعة، وطمس معالمها وإخفاء أثرها؛ ولذلك يقول الغزالي: «ويحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحكاياته، وما جرى بين الصحابة والتشاجر والتخاصم؛ فإنَّه يهيج على بعض الصحابة، والطعن فيهم، وهم أعلام الدين»[109].
وكما تعرّضوا لذكرهم في كتب التراجم والتاريخ، كذلك ورد ذكرهم في مؤلفات الشيعة الرجاليّة والتاريخيّة، وكذلك تعرّضت بعض المؤلفات إلى التفصيل عن المشهورين منهم، ولكن لا على نحو العمل الموسوعي والتفصيلي.
وهذا نقص واضح في مؤلفات الشيعة في هذا المجال؛ إذ لم نلحظ كتاباً اهتمّ بإحصاء أصحاب يزيد في واقعة الطفّ، وتعرّض لذكر تراجمهم بشكل مفصّل وموسوعي.
ومن هنا رأينا تحقيق هذا الأثر القيّم الذي خلّفه المؤرخ والمحدّث السيّد حسن الصدر+، الذي يتعرّض لإحدى الحقائق المهمّة، التي تتعلّق بإحصاء عدد أصحاب يزيد من الجيش الأُموي في واقعة كربلاء، ولعلّه يكون منطلقاً لعمل موسوعي يحصـي عدد مَن اشترك من الجيش الأُموي في واقعة الطفّ ويُترجم لهم، إذ لا شكّ أنَّ لهذا العمل الأثر الكبير في تخليد الواقعة.
تميّز السيّد حسن الصدر بالذكاء الخارق، والحافظة القوية؛ إذ يُستدل مما ورد في هذه الرسالة أنَّه اعتمد على كُتب معدودة، فقال: «فَمَنْ يحضـرني في كتبهم جماعةٌ»، وكذلك في خاتمة الرسالة، قال: «هذا ما يحضـرني من التواريخ وكُتب الآثار، والاستنباطات والاعتبار»، وكذلك ما يحضر في ذهنه وذاكرته.
ولم يتتبع المصادر ويستقصـي الأقوال ويحصـي الآراء؛ إذ كان وقت كتابة هذه الرسالة (ساعتين) فقط، وهذا يدلّ على عبقريته الفذّة وذكائه المُفرط.
وأمّا جوابه عن هذا السؤال، فقد اعتمد فيه على ثلاثة طرائق:
الأُولى: ما ورد في التواريخ وكتب الآثار.
الثانية: الاستنباطات.
الثالثة: الاعتبار.
أمّا في الجانب الأوّل: فقد اعتمد فيه على كُتب العامّة، وهو مراد السائل، وذكر مما ورد في كتاب (مطالب السؤول في مناقب آل الرسول)، لمحمد بن طلحة الشافعي، المتوفى سنة (652هـ)، والثاني كتاب (الفصول المهمّة)، للشيخ نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي، المتوفى سنة (855هـ).
والملاحظ أنَّ المؤلف لم يقتصر على ذكر أقوالهما فقط، بل زاد على ذلك توثيقها من كتب العامّة، وأراد من ذلك أن يُثبت أنَّهما من عظماء علماءِ السُّنة، وأنَّ كتبهما من الكتب المعتمدة لدى أبناء العامّة، وحينئذٍ سيكون كلامهما حُجّةً.
وكذلك اعتمد على كتاب (عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب)؛ لأنَّه من الكتب المعتمدة عند الجميع، كما ذكر.
وأمّا الجانب الثاني، وهو الاستنباطات فكان في أمرين:
ذكر فيه توجيهاً للمؤرخين الذين لم يذكروا هذا العدد، كالمسعودي في مروج الذهب، أو ممّن ذكروا عدداً ولم يُريدوا منه الإحصاء، وهو ما ذكره الطبري، وابن الأثير، وأنَّ ما ذكروه لا يتنافى مع ما ذكره ابن طلحة، وابن الصباغ.
وهذا ما يمكن استنباطه من حديث الطرمّاح في قوله للإمام الحسين×: «وقد رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة، وفيه من الناس ما لم ترَ عيناي في صعيد واحد جمعاً أكثر منه، فسألت عنهم، فقيل: اجتمعوا ليُعرضوا، ثمَّ يُسرّحون إلى الحسين»[110].
وأكدَّ أيضاً العدد المروي في كتب العامّة من كتب الخاصّة، من (مناقب آل أبي طالب)، وما ذكره محمد بن أبي طالب، كما حكاه صاحب البحار.
وأمّا الجانب الثالث وهو الاعتبار: ومراده مما جاء من حوادث في المعركة وما بعدها، ومنها:
أوّلاً: من عدد القبائل التي اشتركت في المعركة، وهي: كندة، وهوازن، وبنو تميم، وبنو أسد، ومذحج، وغيرها من سائر القبائل والجيوش.
إذ يمكن التعرّف على عدد الجيش من خلال اشتراكهم في المعارك السابقة كما في (كندة)، فقد كانوا (اثني عشر ألفاً) يوم صفّين.
ثانياً: إنَّ الجيش الذي يكون فيه عدد الرماة أربعة آلاف كما جاء في الروايات، لا بدّ وأن يكون عدده أكثر من ثلاثين ألف.
ثالثاً: عدد الذين قتلهم الإمام الحسين×، وهو (ألف وتسعمائة وخمسون رجلاً)، وهذا العدد يدلّل على كثرة الجيش الذي خرج لحرب الحسين×.
وذلك في بعض المسائل الواضحة، ومنها قوله: «وقد رأيت في تاريخ ابن جرير يروي أنَّه×: قتل ألفاً وثمانمائة رجل».
ولا شك أنَّه أراد تاريخ ابن جرير الطبري، وهو (تاريخ الأُمم والملوك)، وهذا القول لم يرد فيه، وإنَّما ذُكر في كتاب إثبات الوصية للمسعودي كما سيأتي بيانه.
ومنها ما ذكره من النصّ الذي رواه محمد بن أبي طالب، كما حكاه في البحار وورد فيه (الحصين بن نمير السكوني).
ولم يذكر اسمه الصحيح أو يُنبّه عليه، وقد ذَكَرته بعض كتب التاريخ هكذا، ونقله صاحب أعيان الشيعة بهذا اللقب أيضاً.
والصحيح هو (الحصين بن تميم بن أُسامة بن زهير بن دريد التميمي)، وهو من أهل الكوفة، وكان على شرطة ابن زياد، ووالده (تميم) هو الذي اعترض على الإمام علي× حين كان يخطب على المنبر، ويقول: «سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضل مائة، أو تهدى مائة إلّا نبأتكم بناعقها وسائقها، ولو شئت لأخبرت كلّ واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه»[111].
وأمّا الطبري فذكره في خمسة مواضع من حديثه عن واقعة كربلاء باسم (الحصين بن تميم)، وذكر تارةً أُخرى في الموضوع نفسه باسم (الحصين بن نمير التميمي)، فقال: «وذلك أنَّ عبيد الله بن زياد لمّا بلغه إقبال الحسين بعث الحصين بن نمير التميمي، وكان على شرطه، فأمره أن ينزل القادسية وأن يضع المسالح، فيُنظّم ما بين القطقطانة إلى خفّان، وقدِم الحرّ بن يزيد بين يديه في هذه الألف من القادسية، فيستقبل حسيناً...»[112].
وأمّا (السكوني)، فهو أبو عبد الرحمن حصين بن نمير الكندي، ثمَّ السكوني من أهل حمص، وفي تاريخ دمشق: «كان بدمشق حين عزم معاوية على الخروج إلى صفّين وخرج معه، ووليَ الصائفة ليزيد بن معاوية، وكان أميراً على جند حمص، وكان في الجيش الذي وجّهه يزيد إلى أهل المدينة من دمشق؛ لقتال أهل الحرّة، واستخلفه مسلم بن عقبة المعروف بـ(مُسـرف) على الجيش، وقاتل ابن الزبير، وكان بالجابية حين عُقدت لمروان بن الحكم الخلافة»[113]. وهذا لم يكن في جيش ابن زياد.
وسيأتي في ملاحق هذا الكتاب قول الشيخ محمد السماوي في (إبصار العين في أنصار الحسين×): «أنَّه يمضـي في الكتب (حصين بن نمير السكوني) وهو غلط فاحش»[114].
وكذلك فيما نقله من رواية الطبري: «لمّا خرج عمر بن سعد بالناس كان على ربع أهل المدينة يومئذٍ عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي، وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن ابن أبي سبرة الحنفي...»[115].
ومنها أنّ (الحنفي) تصحيف، والصحيح كما ذكره ابن الأثير في الكامل (عبد الرحمن ابن أبي سبرة الجعفي)، واسم (أبي سبرة) يزيد بن مالك، وعِداده في الكوفيين، وله ولأبيه صحبة كما ورد في كتب التراجم[116].
ذكر بعض المواضيع التي يتطلّبها تحقيق هذه الرسالة
كتب السيّد حسن الصدر+ هذا الجواب المُختصـر، وأراد منه أن يكون الخطوة الأُولى، وبداية المسار في تحقيق هذا الموضوع؛ ولذلك أمر بمراجعة مجموعة من العناوين حتى يكتمل التحقيق، وأوكل تلك المهمّة إلى السيّد السائل، وهو السيّد عبد الحسين خازن الروضة الحسينيّة، إذ قال له في الخاتمة: «وليكن بهذا كفاية لسيّدنا الأجل (أدام الله سُبحانه تأييده)، فقد فُتح له باب تحقيق الحقّ في هذا الباب، فعليه (أدام الله توفيقه) أن يبحث عن عدد العشائر والطوائف المذكورة، وسائر الدلائل والإشارات التي جمعتها له، فإنِّي لا يسعني الوقت لبذل الجهد في الأخذ بمجامع هذه الأشياء على التفصيل، وأعتذر إليه من التقصير، فإنِّي كما لا يخفى عليه في شغل شاغل عن ذلك، والسلام».
ولهذا لا يُسجّل أي قصور حول هذا الجواب المُختصـر، فهو استطاع عبر ما ذكره مما ورد في التواريخ وكتب الآثار، والاستنباطات والاعتبار، أن يُؤكّد من كتب العامّة عدد المُخرَجين لحرب الحسين×، وهو (ثلاثون ألفاً)، وهو العدد الذي ذكره الأئمّة^ في الروايات المشهورة عنهم.
وهنا جملة من الأُمور تتعلّق بصلب تحقيق هذه الرسالة، رأيت أن أذكرها في المقدّمة، ولا أثقل بها هوامش صفحات المتن من الكتاب:
الأمر الأوّل: آراء علماء الشيعة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين×
وهذا الأمر وإن كان خارجاً عن موضوع الرسالة؛ باعتبار أنَّ السائل يطلب معرفة رأي علماء العامّة، ممّن يقول بزيادة عدد المُخرَجين لحرب الإمام الحسين× على الأربعة آلاف، ولكن التحقيق يقتضـي التعرّض لرأي الطرفين في المسألة، مضافاً لورود ذكر أصحابنا في كلام السائل، حيث قال: إنَّه لم يعثرْ على مَن زادَ على ذلكَ (الأربعة آلاف) منهم إلّا علماءُ أصحابنا، فمن المناسب عدم إغفال ذكر آرائهم والتعرّف عليها.
وهنا ثلاثة آراء:
الأوّل: إنَّ عدد المُخرَجين إلى حرب الحسين× ثلاثون ألفاً
وهو ما جاء عن الأئمّة^؛ إذ ورد عنهم في ذلك روايتان ذكرهما الشيخ الصدوق:
الأُولى: عن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه×: «إنَّ الحسين بن علي بن أبي طالب× دخل يوماً إلى الحسن×، فلمّا نظر إليه بكى، فقال له: ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: أبكي لمِا يُصنع بك. فقال له الحسن×: إنَّ الذي يُؤتى إليَّ سمٌّ يُدس إليَّ، فأُقتل به، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك (ثلاثون ألف) رجل، يدّعون أنَّهم من أُمّة جدّنا محمد|، وينتحلون دين الإسلام، فيجتمعون على قتلك، وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك، فعندها تحلّ ببني أُميّة اللعنة، وتمطر السماء رماداً ودماً، ويبكي عليك كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات، والحيتان في البحار»[117].
الثانية: عن ثابت بن أبي صفية، قال: «نظر سيّد العابدين علي بن الحسين× إلى عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب فاستعبر، ثمَّ قال: ما من يوم أشدّ على رسول الله’ من يوم أُحد، قُتل فيه عمّه حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة قُتل فيه ابن عمّه جعفر بن أبي طالب. ثمَّ قال×: ولا يوم كيوم الحسين× ازدلف إليه (ثلاثون ألف رجل)، يزعمون أنَّهم من هذه الأُمّة، كلّ يتقرّب إلى الله (عزّ وجلّ) بدمه، وهو بالله يُذكّرهم فلا يتعظون، حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً»[118].
وهذا العدد (ثلاثون ألفاً) الذي ورد في هذه الروايات، هو الذي أراد السيّد حسن الصدر+ إثباته من طرق العامّة.
الثاني: إنَّ عدد المُخرَجين إلى حرب الحسين× هو (سبعون ألفاً)
وهذا الرأي ذكره السيّد هاشم البحراني، فقال: «... في كتب الأوّلين رُويَ أنَّه لمّا جمع ابن زياد قومه (لعنهم الله جميعاً) لحرب الحسين×، كانوا سبعين ألف فارس، فقال ابن زياد: أيّها الناس، مَن منكم يتولى قتل الحسين× وله ولاية أي بلد شاء...»[119]. ونقل هذا الرأي العلّامة المجلسـي، حيث قال: «أقول: وجدت في بعض مؤلفات المعاصرين، أنَّه لمّا جمع ابن زياد (لعنه الله) قومه لحرب الحسين×، كانوا سبعين ألف فارس...»[120].
الثالث: إنَّ عدد المُخرَجين مليون راجل وستمائة ألف فارس
وهذا العدد ذكره الدربندي[121]، قال: «إنَّ الجيش المُحارب للحسين× يوم كربلاء بلغ مليوناً وستمائة ألف: مليون راجل، وستمائة ألف فارس».
وورد أيضاً فيه[122]، وفي (اللؤلؤ والمرجان): «إنَّ الحسين قتل يوم عاشوراء عشـرة آلاف، وبعضهم قال: اثني عشر ألفاً، وبعضهم: خمسين ألفاً، وآخر: أربعمائة ألف رجل»[123].
وأمّا عن زمن الواقعة، فقال الدربندي: «إنَّ يوم عاشوراء امتدّ إلى اثنتين وسبعين ساعة؛ وذلك لأنَّ الحوادث الكثيرة الواقعة يوم عاشوراء يستبعد وقوعها في نهار عادي»[124].
وقد قال سماحة الشيخ المقدسي: «وهذا العدد يحتاج إلى حرب دامية تستمر عدّة أيّام، بل عدّة أسابيع، خصوصاً مع النظر إلى وسائل القتال البدائية آنذاك، والمفروض أنَّ الإمام الحسين كان يُقاتل بصورة عادية لا على نحو الإعجاز، وهذا العدد أشبه بالأساطير التي تُحاك ـ عادة ـ حول العظماء. ثمَّ إنَّ عظمة الحسين لا تعتمد على بلوغ قتلاه هذا الرقم الخيالي... وقد أورد المسعودي، وابن شهر آشوب أرقاماً للقتال واقعية ومقبولة، قال المسعودي في (إثبات الوصية: ص168): وروي أنَّه قتل بيده ذلك اليوم ألفاً وثمانمائة مقاتل. وأمّا ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب: ج4، ص110، فقد أوصل القتلى إلى ألف وتسعمائة وخمسين قتيلاً»[125].
وأمّا عن زمن الواقعة ووقتها، فقال الدربندي: «لم يفكّر هذا القائل بما يخلقه هذا القول الغريب من تساؤلات وشبهات بالنسبة للقوانين الكونيّة، إضافة إلى مجافاته للواقع، وعدم اعتماده على مصدر صحيح وعقلائيّ. ثمَّ إنَّ الموضوع لم يكن من موارد الكرامات والمعاجز التي هي فوق الإدراك العقلي، والتي لا بدّ من الإذعان بها كما أنَّ القائل لم يعتمد على رواية، بل هو مجرد استنتاج منه»[126].
وهناك أجوبة أُخرى عن هذا الرأي الثالث ذكرها الشيخ المطهري في (الملحمة الحسينيّة)[127].
دلالة القول بعدد المُخرَجين وأنَّهم (سبعون ألفاً)
يبقى الرأي الثاني، وهو أنَّ عدد المُخرَجين (سبعون ألفاً)، وهو الذي أشار له السيّد البحراني في مدينة المعاجز ورواه مرسلاً، ونقله الشيخ المجلسـي في البحار، ولم يُعلّق عليه، وهو قوله: «... في كُتب الأوّلين، رُويَ أنَّه لمّا جمع ابن زياد قومه (لعنهم الله جميعاً) لحرب الحسين×، كانوا سبعين ألف فارس...». وهنا لا يُعلم هل نقل السيّد البحراني هذا الرأي من كتاب ينقل عن كُتب الأوّلين، أو هو اطّلع عليها؟
أقول: لعلّه ـ والله العالم ـ إنَّ السيّد البحراني أو مَن ذَكَرَ ذلك الرأي من الأوّلين، اعتمد على حديث رواه العامّة من أصحاب المذاهب الأربعة، وأثبتوه في مصنفاتهم الحديثية ومسانيدهم وتواريخهم، فقد روى الحاكم بإسناده إلى سعيد بن جبير، عن ابن عباس (رضي الله عنهما)، قال: «أوحى الله تعالى إلى محمد|: أنِّي قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفاً، وأنِّي قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً»[128]. هذا لفظ حديث الشافعي. وفي حديث القاضي أبي بكر بن كامل: «إنِّي قتلت على دم يحيى بن زكريا، وإنِّي قاتل على دم ابن ابنتك»[129]. وقال عنه الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه»[130].
ونقل الشيخ النمازي عن التفسير المنسوب للإمام العسكري×: «أنَّه يُقتل بشهادة الحسين× سبعين ألفاً وسبعين ألفاً مكرراً»[131].
ولكن يرد عليه أنَّه ذكر عدد الُمخرَجين (سبعين ألفاً)، وهذا يتعارض مع ما ذُكر في الحديث؛ إذ يكون المجموع مائة وأربعين ألفاً.
تأويل قتل سبعين ألفاً أو مائة ألف بشهادة الحسين×
ويمكن تأويل هذا العدد، فيقال: إنَّ العدد الأوّل وهو سبعون ألفاً يُقسم على صنفين:
الصنف الأوّل: هم الذين أُخرجوا لحرب الحسين×، ووصل منهم إلى طفّ كربلاء (ثلاثون ألفاً)، أي: المباشرون للحرب والقتال.
الصنف الثاني: هم مَن كانوا في طريقهم إلى كربلاء لقتال الإمام الحسين×.
وأمّا العدد المكرر، فهو يتناول الُمحرّضين والُمتفرّجين، ومَن سمعوا باستنصار الحسين× ولم يجيبوه، وكذلك كلّ مَن رضي بما أقدم عليه جيش يزيد في واقعة الطفّ.
ودلّ على ذلك ما روي في (عيون أخبار الرضا×) عن الهروي، قال: «قلت لأبي الحسن الرضا×: يا بن رسول الله، ما تقول في حديث رُويَ عن الصادق×، أنَّه قال: إذا خرج القائم (عجّل الله فرجه)، قتل ذراري قتلة الحسين× بفعال آبائها؟
فقال×: هو كذلك. فقلت: وقول الله (عزّ وجلّ): (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[132]، ما معناه؟
فقال: صدق الله في جميع أقواله، ولكن ذراري قتلة الحسين× يرضَوْن بفعال آبائهم، ويفتخرون بها، ومن رَضِيَ شيئاً كان كمَن أتاه، ولو أنَّ رجلاً قُتل بالمشـرق، فرضي بقتله رجلٌ بالمغرب لكان الراضي عند الله (عزّ وجلّ) شريك القاتل، وإنَّما يقتلهم القائم (عجّل الله فرجه) إذا خرج؛ لرضاهم بفعل آبائهم»[133].
ومن هذا المعنى ما رُوي عن الإمام الصادق×، أنَّه قال: «قُتل بالحسين مائة ألف، وما طُلب بثأره، وسيُطلب بثأره»[134].
ولا أعلم، هل كان على السيّد حسن الصدر+ أن يذكر هذا الحديث مع ما ذكره من آراء المُحدّثين، كابن الصباغ، وابن طلحة؛ لأنَّه ورد في كتب أهل السنّة، ويستنبط منه عدد المُخرَجين إلى حرب الإمام الحسين×؟
الأمر الثاني: بدء استعداد الجيوش وتتابعها إلى كربلاء
استعداد الجيش الأُموي منذُ تحرّك الحسين× من المدينة
قد يقال: إنَّ هذه الكثرة من الجيوش، والتي تقدّر بـ(ثلاثين ألفاً) لا يمكن الإعداد لجميع ما يحتاجه هذا العدد من السلاح والمُؤَن وغيرها.
والجواب: إنَّ هذه الجيوش لم يكن إخراجها إلى حرب الإمام الحسين× طارئاً، بل كان الاستعداد منذُ أن تحرّك الإمام الحسين× من المدينة المنورة، وكان هناك الكثير من قادة الجيش، أو غيرهم يعرفون بما تؤول إليه الأُمور؛ إذ عرفوا ذلك من خلال الأخبار الواردة عن النبيّ وأهل بيته^، فاستعدوا لذلك.
وفي كتب العامّة: رُويَ عن محمد بن سيرين، عن بعض أصحابه، قال: قال علي× لعمر بن سعد: «كيف أنت إذا قمت مقاماً تُخيَّر فيه بين الجنّة والنار، فتختار النار»[135].
وأكّد تلك العاقبة عمر بن سعد بعد مُنصرفه من قتله الحسين×.
قال الدينوري: «ورُويَ عن حميد بن مسلم، قال: كان عمر بن سعد لي صديقاً، فأتيته عند مُنصرفه من قتال الحسين، فسألته عن حاله؟ فقال: لا تسأل عن حالي، فإنَّه ما رجع غائب إلى منزله بشرٍّ مما رجعت به، قطعت القرابة القريبة، وارتكبت الأمر العظيم»[136].
وقد أكّد ذلك المؤرخون وكُتّاب السِّيَر والمُحققون، أنَّ ذلك الجيش كان يُعدُّ منذُ أشهر.
«فالأخبار والروايات التاريخيّة، تكشف عن المراقبة الشديدة لحركة الحسين×، منذُ انطلاقه من المدينة وحتى نزوله في كربلاء، مروراً بأحداث إقامته في مكة لعدّة أشهر، ولم يكن مقتل الحسين في كربلاء بالأمر المفاجئ، كما يُريد البعض أن يصوّره بالنسبة لمركز الخلافة في الشام.
وذلك يندرج في سياق المحاولات التي تستهدف إسباغ ثوب البراءة على يزيد بن معاوية، وتحميل عبيد الله بن زياد كامل المسؤولية، وإثبات عدم الرضا من قِبل يزيد عندما بلغه خبر مقتل الحسين×»[137].
ونذكر لذلك شاهداً على استعداد ذلك الجيش قبل حدوث الواقعة، فقال الشيخ المفيد: «وكان عبيد الله بن زياد أمرَ، فأُخذَ ما بين واقصة[138] إلى طريق الشام إلى طريق البصـرة، فلا يَدَعُون أحداً يلجُ ولا أحداً يخرج، وأقبل الحسين× لا يشعر بشـيء حتى لقيَ الأعراب، فسألهم. فقالوا: لا والله ما ندري، غير أنَّا لا نستطيع أن نلج (أو نخرج)، فسار تلقاء وجهه×»[139].
الروايات الواردة في عدد المُخرَجين وأوقات قدومهم لكربلاء
قال السيّد ابن طاووس: «وخرج عمر بن سعد لقتال الحسين× في أربعة آلاف فارس، واتبعه ابن زياد(لعنه الله) بالعساكر، حتى تكمّلت عنده إلى ست ليال خلون من محرّم عشـرون ألف فارس، ثمَّ تكاملت الجيوش إلى ثلاثين ألفاً»[140].
وأكد ابن أعثم التئام العساكر لست مضين من المحرّم، فقال: «وكان عبيد الله بن زياد في كلّ وقت يبعث إلى عمر بن سعد، ويستعجله في قتال الحسين، قال: والتأمت العساكر إلى عمر بن سعد لست مضين من المحرّم»[141].
وهذا يعني أنَّ إمداد الجيوش وتسييرها توقف بعد اليوم السادس.
ولكن يدلّ على أنّ تسريب الجيوش بقيَ متواصلاً حتى بعد اليوم السادس من المُحرّم أمران:
الأوّل: وهم (العشرة آلاف) الذين اكتمل العدد بهم، فكان ثلاثين ألفاً، وهو في الروايات القائلة إنَّ العدد بلغ عشرين ألفاً لست مضين من المُحرّم.
ثانياً: ما رواه ابن سعد في (طبقاته) من أنَّ شمر قدِم لتسع خلون من المُحرّم، قال: «وقال لشمر بن ذي الجوشن: سر أنت إلى عمر بن سعد، فإن مضـى لمِا أمرته، وقاتل حسيناً، وإلّا فاضرب عنقه، وأنت على الناس.
قال: وجعل الرجل والرجلان والثلاثة يتسللون إلى حسين من الكوفة، فبلغ ذلك عبيد الله، فخرج فعسكر بالنُّخيلة، واستعمل على الكوفة عمرو بن حريث، وأخذ الناس بالخروج إلى النُّخيلة، وضبط الجسر فلم يترك أحداً يجوزه. وعقد عبيدُ الله لحصين بن تميم الطهوي[142]على ألفين، ووجّهه إلى عمر بن سعد مَدَداً له. وقدِم شمر بن ذي الجوشن الضبابي على عمر بن سعد بما أمره به عبيد الله عشية الخميس لتسع خلون من المُحرّم، سنة إحدى وستين بعد العصر»[143].
أقول: إن صحّت هذه الرواية، فتأويلها أنَّه بعد أن وصل قبل اليوم السادس من المُحرّم، رجع بعدها إلى عبيد الله بن زياد، وهو إمّا في النُّخيلة أو في الكوفة، ثمَّ عاد مرّة أُخرى في اليوم التاسع من المُحرّم.
وهذا الموضوع يحتاج إلى بحث وتحقيق موسّع؛ لأنَّ أكثر المُحدّثين يقولون: أقبل بجيشه قبل اليوم التاسع، ومنهم ابن الصباغ في (الفصول المهمّة)، قال: «وأوّل مَن خرج مع عمر بن سعد الشمر بن ذي الجوشن في أربعة آلاف فارس»[144].
تفصيل السيّد محسن الأمين تسريب الجيوش من الكوفة إلى الطفّ
وقد فصّل السيّد محسن الأمين تتابع الجيوش وتسـريبها من الكوفة إلى كربلاء، في نقله أقوال المؤرخين، فقال: «وسار ابن سعد إلى قتال الحسين× بالأربعة آلاف التي كانت معه، وانضمّ إليه الحرّ وأصحابه، فصار في خمسة آلاف، ثمَّ جاءه شمر في أربعة آلاف، ثمَّ أتبعه ابن زياد بيزيد بن ركاب الكلبي في ألفين، والحصين بن تميم السكوني في أربعة آلاف، وفلان المازني في ثلاثة آلاف، ونصـر ابن فلان في ألفين، فذلك عشرون ألف فارس تكمّلت عنده إلى ست ليال خلون من المحرّم. وبعث كعب بن طلحة في ثلاثة آلاف، وشبث بن ربعي الرياحي في ألف، وحجار بن أبجر في ألف، فذلك خمسة وعشرون ألفاً. وما زال يُرسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده ثلاثون ألفاً ما بين فارس وراجل. هكذا ذكره المفيد في الإرشاد، وهو المروي عن الصادق×.
وقال الطبري في التاريخ: أقبل ابن سعد في أربعة آلاف من أهل الكوفة حتى نزل بالحسين.
وقال سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص: كان ابن زياد قد جهّز عمر بن سعد لقتال الحسين في أربعة آلاف، وجهّز خمسمائة فارس، فنزلوا على الشرائع.
وقال المسعودي: كان جميع مَن حضـر مقتل الحسين من أهل الكوفة خاصّة. ثمَّ قال الطبري: إنَّ أصحاب ابن سعد كانوا ستة آلاف مقاتل.
أقول: كلام سبط ابن الجوزي ليس فيه دلالة على أنَّ جميع أصحاب ابن سعد كانوا أربعة آلاف؛ لأنَّ الذين جاءوا معه كانوا أربعة آلاف في جميع الروايات، ثمَّ أتبعه ابن زياد ببقيّة العسكر، كما قال المفيد، وانضمّ إليه الحرّ بمَن معه. والقول بأنَّهم كانوا ستة آلاف مردود بما مرَّ عن المفيد، والمُثبِت مُقدّم على النافي»[145].
تفصيل آخر لتتابع الجيوش إلى الطفّ
وهناك تفصيل آخر ذَكَره مُحقق (الفصول المهمَّة)، نذكره لمعرفة المصادر التاريخية الأُخرى، التي اُعتمدت في معرفة عدد المُخرَجين إلى حرب الإمام الحسين×، قال: «كان مع الحرّ بن يزيد ألف فارس، ثمَّ سار مع عمر بن سعد بن أبي وقاص أربعة آلاف، فصاروا خمسة آلاف.
فإذا لقي الشمر مع أربعة آلاف صار عِدادهم تسعة آلاف، ثمَّ أتبعه زيد بن ركاب الكلبي في ألفين، والحصين بن نمير السكوني[146] في أربعة آلاف، والمصاب المازني في ثلاثة آلاف، ونصـر بن حربة في ألفين فتمَّ له عشرون ألفاً، ثمَّ أتبعه بحجار بن أبجر في ألف فارس، فصار عمر بن سعد في اثنين وعشرين ألفاً[147] ما بين فارس وراجل»[148][149].
أمّا صاحب ينابيع المودّة، فقال: «حتى أحاطوا الحسين في أربعين ألف فارس».
وفي أمالي الشيخ الصدوق، عن الإمام الصادق× ثلاثون ألفاً، وفي مطالب السؤول أنَّهم عشرون ألفاً، وفي هامش تذكرة الخواص أنَّهم مائة ألف، وفي تحفة الأزهار لابن شدقم ثمانون ألفاً، وفي أسرار الشهادة ستة آلاف فارس، وألف ألف راجل.
ولم يذكر أبو الفداء في تاريخه غير خروج ابن سعد في أربعة آلاف والحرّ في ألفين.
وفي عمدة القاري للعيني: كان جيش ابن زياد ألف فارس، رئيسهم الحرّ، وعلى مقدّمتهم الحصين بن نمير[150].
وهذا من أعجب العجائب؛ لأنَّه مخالف لِما ذكره أصحاب السِّيَر والتاريخ[151].
الأمر الثالث: تحقيق في عدد المُخَرجين إلى حرب الحسين× في كربلاء
لاشكّ أنَّ هناك اختلافاً بين المؤرخين فيما رووه في عدد القبائل والعساكر؛ إذ بعضهم يوافق فيما يذكره آخر، وبعضٌ يزيد على آخر أو ينقص عنه، وهنا جملة مسائل:
أوّلاً: تتابع الجيوش إلى كربلاء.
1ـ قدوم (خمسة آلاف) مقاتل إلى اليوم الثالث من المُحرّم[152]، وهم:
ـ جيش الحرّ بن يزيد الرياحي، وعدده (ألف) مقاتل من تميم.
ـ جيش عمر بسعد الذ ي أعدّ لـ (دستبى)، وعدده (أربعة آلاف).
2ـ ومن اليوم الثالث إلى اليوم السادس وصل كلّ من:
ـ شمر بن ذي الجوش في (أربعة آلاف) مقاتل من هوازن.
ـ يزيد بن ركاب الكلبي في (ألفين) مقاتل من قضاعة.
ـ الحصين بن تميم التميمي في (أربعة آلاف)، وكان على ربع تميم.
ـ مضاير بن رهينة المازني في (ثلاثة آلاف) من مذحج.
ـ نصر بن حرشة في (ألفين).
وذلك عشرون ألف فارس تكمّلت إلى ست ليال خلون من المحرّم.
3ـ وابتدأ من اليوم السابع وصول كلّ من:
ـ كعب بن طلحة في (ثلاثة آلاف).
ـ و(شبث بن ربعي الرياحي) في (ألف)[153].
ـ حجار بن أبجر بن جابر العجلي[154] في (ألف) من بكر بن وائل.
فذلك خمسة وعشرون ألفاً.
ثمَّ قال المؤرخون: «وما زال يُرسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده (ثلاثون ألفاً)، ما بين فارس وراجل»[155].
وما تقدّم من تصنيف هو شبه إجماع لدى المؤرخين، وهو الذي ذكره السيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة، وابن شهر آشوب في المناقب، ومحمد بن أبي طالب في مقتله.
ثانياً: يُعرف مما رواه المؤرخون أنَّ تقسيم البعوث كان على شكل (آلاف)، أي: إنَّ على كلّ (ألف) قائد عسكري.
ومن هنا يكون عدد قادة الجيش ثلاثين قائداً عسكرياً مع الجيش الأُموي على الأقل، من غير قادة القبائل. ويصطلح على هذا القائد بـ(الأمير).
وإذا اجتمعت عدّة آلاف قد يكون عليهم قائد رئيس، ويكون تحت إمرته مجموعة من القادة، وكلّ قائد على(ألف)، ويصطلح عليه بـ (أمير الأمراء).
وقد وجِدت هذه الأقسام والمصطلحات في تلك الفترة، ومنها: «لمّا انتهى إلى يزيد بن معاوية مبايعة أهل تهامة والحجاز لعبد الله بن الزبير، ندب له الحصين بن نمير السكوني، وحبيش بن دلجة القيني، وروح بن زنباع الجذامي، وضمّ إلى كلّ واحد منهما جيشاً، واستعمل عليهم جميعاً مسلم بن عقبة المرّي، وجعله أمير الأمراء»[156].
وتطبيقه هنا ـ على سبيل المثال ـ في الجيش الذي قدِم مع عمر بن سعد الذي أُعدّ لـ(دستبى)، وعددهم أربعة آلاف، وهؤلاء يجب أن يكونوا مع عمر بن سعد الذي هو أمير الأمراء، أربعة من الأمراء قادة للعسكر، وهم: عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي، وعبد الرحمن ابن أبي سبرة الحنفي (الجعفي)، وقيس بن الأشعث بن قيس، ورجل من تميم[157].
ومثله الحصين بن تميم التميمي، فكان على أربعة آلاف، بعثه عبيد الله عندما سمع بمجيء الإمام الحسين× إلى القادسية. وهذا أيضاً يجب أن يكون تحت إمرته أربعة من القادة الأمراء، وذكروا أنَّ أحدهم هو الحرّ بن يزيد الرياحي، الذي بعثه الحصين مع ألف مقاتل لملاقاة الإمام الحسين×.
قال الشيخ المفيد: «وكان مجيء الحرّ بن يزيد من القادسية، وكان عبيد الله بن زياد بعث الحصين بن نمير[158] وأمره أن ينزل القادسية، وتقدّم الحرّ بين يديه في ألف فارس يستقبل بهم حسيناً»[159].
وهنا ملاحظة: ذكروا بأنَّ الحصين أقبل بأربعة آلاف إلى كربلاء، ولعلّ الصحيح هو ثلاثة آلاف؛ لأنَّ (الألف) الذي كان تحت إمرته بقيادة الحرّ بن يزيد أرسله لملاقاة الإمام الحسين×، ووصل قبل الحصين إلى كربلاء، إلّا أن يقال: ضمَّ إليه ألف مقاتل؛ لأنَّهم ذكروا أنَّه كان على الرماة في معركة كربلاء (أربعة آلاف).
وأكد ذلك البعث البلاذري، فقال: «قالوا: ولمّا بلغ عبيد الله بن زياد إقبال الحسين إلى الكوفة بعث الحصين بن [تميم بن] أُسامة التميمي ـ ثمَّ أحد بني جشيش بن مالك بن حنظلة ـ صاحب شرطه حتى نزل القادسية، ونظّم الخيل بينها وبين خفّان، وبينها وبين القطقطانة إلى لعلع»[160].
وهذا القول بحاجة إلى تحقيق أيضاً إلّا أن يقال: إنَّ هؤلاء الأربعة آلاف الرماة هم غير الأربعة أو الثلاثة آلاف الذين قدِموا مع الحصين؛ إذ لا يُعقل ـ على الأقل ـ أنَّ الجيش الذي كان مع الحرّ كلّهم من الرماة.
وقد ذكر المؤرخون
أسماء بعض القادة الذين اعتمد عليهم عبيد الله بن زياد، ومنهم: عمر بن سعد، شمر بن
ذي الجوشن، الحصين بن تميم، الحرّ بن يزيد الرياحي
ـ قبل انتقاله إلى معسكر الحسين× ـ حجار بن أبجر، شبث بن ربعي، عمرو بن الحجاج
الزبيدي، الحارث بن يزيد بن رويم، عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي، عبد الرحمن
ابن أبي سبرة (الجعفي)، قيس بن الأشعث بن قيس، رجل من تميم، عروة بن قيس.
ثالثاً: وإلى جانب ذلك، كان هناك رؤساء القبائل الذين أقبلوا مع قبائلهم، وهؤلاء قد يكون بعضهم من قادة الجيش، وبعضهم ليس له موقع في قيادة الجيش.
ومن الذين قادوا قبائلهم وقد يكون بعضهم من قادة العسكر الأمراء، مثل: قيس بن الأشعث، وهلال الأعور، وغيهمة بن أبي زهير، والوليد بن عمرو.
وهناك الكثير من رؤساء قادة القبائل ممّن حضـروا الطفّ مع عمر بن سعد وإحصائهم ليس هذا محلّه.
وقد ورد لفظ رؤساء القبائل في كتب التاريخ والمقاتل، ومنه حين أراد عمر بن سعد بعث عروة بن قيس الأحمسي للإمام الحسين×، وقال له: ائته فسله ما الذي جاء بكَ، وماذا تُريد؟
وكان عروة ممّن كتب إلى الحسين×، فاستحيا منه أن يأتيه، فعرض ذلك على (الرؤساء) الذين كاتبوه، فكلّهم أبى ذلك وكرهه[161].
رابعاً: إنَّ القادة العسكريين لم يبقوا على حالهم في الإمرة السابقة، وإنَّما حدث تشكيل جديد، وأصبح الجميع تحت إمرة عمر بن سعد، وقد لا يبقى كلّ ألف تحت إمرة قائد، فقد يُبعث أربعمائة أو خمسمائة مع قائد في مهمّة معينة، وقد يتجمع هذا الألف في كربلاء بعد أن يأتي متفرّقاً؛ إذ «جعل ابن زياد يُرسل العشـرين والثلاثين والخمسين إلى المائة، غدوةً، وضحوةً، ونصف النهار، وعشيةً من النُّخيلة؛ يمدُّ بهم عمر بن سعد»[162].
وقد يحدث تغيير في بعض من القادة، فذكروا أنَّ الحصين بن تميم أصبح على الرماة كما في كتب المقاتل.
وقد ذكر الطبري كما في رواية أبي مخنف، عن عمرو الحضـرمي أسماء القادة الذين عيّنهم عمر بن سعد، فقال: «لمّا خرج عمر بن سعد بالناس، كان على ربع أهل المدينة يومئذٍ عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي[163]، وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن ابن أبي سبرة الحنفي[164]، وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى ربع تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الرياحي[165]. فشهد هؤلاء كلّهم مقتل الحسين إلّا الحرّ بن يزيد؛ فإنَّه عدل إلى الحسين وقُتل معه.
وجعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى ميسـرته شمر بن ذي الجوشن بن شرحبيل بن الأعور بن عمر بن معاوية، وهو الضباب بن كلاب، وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسـي، وعلى الرجالة شبث بن ربعي اليربوعي، وأعطى الراية ذويداً مولاه»[166].
خامساً: نُذكّر هنا بأنَّه لا يمكن القطع بكلّ ما يُذكر في هذه الروايات؛ للاختلاف والتضارب بينها.
فهنا يقول: أقبلت مذحج وأسد وعليها عبد الرحمن ابن أبي سبرة الحنفي (الجعفي)، بينما فرّقت بعض الروايات بينهما بعد رجوعهما، فذكرت أنَّ مذحجاً جاءت بسبعة أرؤس، وجاءت بنو أسد بستة أرؤس مع هلال بن الأعور.
وكذلك في قوله: «وعلى ربع تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الرياحي»، وفي أكثر الروايات أنَّ الحصين بن تميم هو الذي كان عليهم، والحرّ بن يزيد كان تحت إمرته.
وقالوا أيضاً: «وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً مع الحصين بن نمير».
ومن هنا لا يمكن الاعتماد على هذا التقسيم الوارد في رواية الطبري لوحدها والتي استدل بها الأُستاذ أحمد حسين يعقوب على أنَّ «الجيش الأُموي... مُقسَّم إلى أربع فرق: فرقة أهل المدينة ويقودها عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي، وفرقة مذحج وأسد ويقودها عبد الله بن سبرة الحنفي (الجعفي)، وفرقة ربيعة وكندة ويقودها قيس بن الأشعث، وفرقة تميم وهمدان ويقودها الحرّ بن يزيد الرياحي»[167].
وهو غير صحيح؛ إذ جيش عمر بن سعد مُقسّم على عدّة أصناف، أضف إلى ذلك أنَّ التصنيف الوارد في الرواية ليس بصدد الحصـر، كما جاء فيها حين قال: «جعل عمر ابن سعد على ميمنة جيشه عمرو بن الحجاج الزبيدي، وسلّم قيادة الميسـرة لشمر بن ذي الجوشن العامري، وعلى الخيل عزرة بن قيس الأحمسي، وعلى الرجالة شبث بن ربعي»[168].
وهنا صنف آخر مهم وهو صنف (الرماة)، ولم يُذكر في أصناف رواية الطبري، وفي حديث عروة بن قيس مع عمر بن سعد، إذ قال له: «أما ترى ما تلقى خيلي منذُ اليوم من هذه العدّة اليسيرة [ويقصد أصحاب الحسين]، ابعث إليهم الرجال والرماة»[169].
وكان قائد (الرماة) الحصين بن تميم التميمي.
وفي المقاتل: «فلمّا رأى الحصين بن نمير ـ وكان على الرماة ـ صبرَ أصحاب الحسين× تقدّم إلى أصحابه ـ وكانوا خمسمائة نابل ـ أن يرشقوا أصحاب الحسين× بالنبل، فرشقوهم، فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم وجرحوا الرجال وأرجلوهم»[170].
وفي حديث شمر بن ذي الجوشن أنَّه «أمر الرماة أن يرموه، فرشقوه بالسهام حتى صار كالقنفذ، فأحجم عنهم، فوقفوا بإزائه. ونادى شمر: ويحكم ما تنتظرون بالرجل ثكلتكم أُمّهاتكم»[171].
وفي رواية محمد بن أبي طالب، وابن شهر آشوب في المناقب: «وكانت الرماة أربعة آلاف، فرمُوه بالسهام»[172].
وهناك صنف آخر من المقاتلين أُشير لهم بصفّين، فذكر نصـر بن مزاحم أنَّه «كان بصفّين أربعة آلاف محجف من عنزة»[173].
وكذلك هناك صنف آخر من عدّة الجيش، ويصطلح عليه بـ (المجففة)، وفي تاريخ الطبري، وكتب المقاتل: «ودعا عمر بن سعد الحصينَ بن تميم، فبعث معه المجفّفة وخمسمائة من المرامية، فأقبلوا حتى إذا دنوا من الحسين وأصحابه رشقوهم بالنبل، فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم وصاروا رجّالة كلّهم»[174].
والمجفّفة: هي من أصناف الخيل التي تشترك في الحرب ويقابلها المجردة.
وقال ابن الأثير: «التجفاف ما يُجلّل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح. وفرس مجفّف عليه تجفاف. والجمع التجافيف، والتاء فيه زائدة... »[175].
وفي حديث الحديبية: «فجاء يقوده إلى رسول الله (صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) على فرس مجفّف، أي: عليه تجفاف، وهو شيء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى. وقد يلبسه الإنسان أيضاً، وجمعه تجافيف»[176].
ثمَّ أضف إلى ذلك أنَّ رواية الطبري المتقدّمة التي اعتمدها الأُستاذ أحمد حسين يعقوب غير واضحة، فقوله: «لمّا خرج عمر بن سعد بالناس»، يوحي بأنَّ القادة الذين ستُذكر أسماؤهم هم ممّن كانوا معه في الأربعة آلاف التي أعدّت لـ (دستبى)، وهم:
ـ عبد الله بن زهير بن سُليم الأزدي على أهل المدينة.
ـ عبد الرحمن بن أبي سبرة الحنفي (الجعفي) على مذحج وأسد.
ـ قيس بن الأشعث بن قيس على ربيعة وكندة.
ـ الحرّ بن يزيد الرياحي على ربع تميم وهمدان.
ولكن يرد على هذا أنَّ الحرّ بن يزيد لم يأتِ مع عمر بن سعد، وإنَّما كان مع الحصين بن تميم، وعلى هذا إمّا أن يكون معنى الجملة «لمّا خرج عمر بن سعد بالناس»، أي: حين اكتملوا وصاروا جميعهم تحت إمرته في الطفّ.
وإمّا أن يكون هناك قائد رابع لم يذكر اسمه، وذكر في محلّه اسم الحرّ بن يزيد الرياحي. وهو الذي أشار إليه ابن نما في مثير الأحزان حين قال: «وعلى تميم وهمدان رجلاً من تميم»[177].
ومن هنا أقول: لا يمكن الاعتماد على رواية الطبري لوحدها؛ لأنَّ التقسيم الحقيقي لذلك الجيش وتصنيفه لم يصل إلينا بشكل دقيق، وأذكرُ مثالاً لتقسيم الجيوش في تلك العصور، حتى يكون لدى القارئ تصوّر عن تقسيم الجيوش آنذاك.
ومثاله من معركة اليرموك، فجعل القائدُ العسكرَ ثلاثة صفوف: صف فيه الرماة من أهل اليمن، وصف فيه أصحاب السيوف والحجف، وصف فيه الرماح والخيل والعدّة.
«وقسم الخيّالة ثلاثة صفوف... وكان على الدراجة شرحبيل بن حسنة، وعلى الميمنة يزيد بن أبي سفيان، وعلى جناح الميسـرة قيس بن هبيرة المرادي، وكانت الأزد في ذلك اليوم في القلب، وحمير وهمدان ومذحج، وخولان وخثعم وكنانة، وقضاعة ولخم وجذام وحضرموت ميمنة وميسرة، ولم يكن فيهم تيم ولا ربيعة؛ لأنَّهم كانوا في العراق مع سعد بن أبي وقاص»[178].
سادساً: لم يذكر المؤرخون بقيّة الجيش الذي وصل بعد اليوم السادس، ويجب أن يكون عدده (عشرة آلاف)، فاقتصروا على ذكر قدوم (خمسة آلاف)، وهم: كعب بن طلحة في (ثلاثة آلاف)، وشبث بن ربعي الرياحي في (ألف)، وحجار بن أبجر في (ألف).
ولم يذكروا الـ (خمسة آلاف) الأُخرى، ويقتصـرون بـقولهم: (حتى تكامل الجيش ثلاثين ألفاً). ويمكن تحديد القادة الذين أقبلوا ببقيّة الجيش من بعد اليوم السادس، وهم:
1ـ هلال بن الأعور، وكان على بني أسد.
2ـ عيهمة بن زهير، وكان على الأزد.
3ـ الوليد بن عمرو، وكان على ثقيف.
وعُرف هؤلاء من خلال مجيئهم بالرؤوس على رواية الدينوري، فقال: «... وحُملت الرؤوس على أطراف الرماح، وكانت اثنين وسبعين رأساً... وجاءت بنو أسد بستة رؤوس مع هلال بن الأعور، وجاءت الأزد بخمسة رؤوس مع عيهمة بن زهير، وجاءت ثقيف باثني عشر رأساً مع الوليد بن عمرو»[179].
وهؤلاء لا يختلفون عن هوازن، أو تميم، أو كندة، أو ربيعة، أو غيرهم من القبائل، فلا شكّ أنَّهم أقبلوا بقبائلهم، ولهم ميزة بقتلهم لأصحاب الحسين× وحملهم الرؤوس.
إذ كانت القبائل تتنافس فيما بينهم في قتل أكثر عدد من أصحاب الإمام الحسين×، والحصول على أكثر عدد من رؤوس القتلى.
وعلى ما حملوا من رؤوس يمكن تحديد العدد الذي أقبل مع كلّ واحد من هؤلاء، ويكون:
ـ الوليد بن عمرو، وأقبل معه (ألف) من ثقيف.
ـ هلال بن الأعور، وأقبل معه (ألف) من بني أسد.
ـ عيهمة بن زهير، وأقبل معه (ألف) من الأزد.
ـ عروة بن قيس الأحمسي، معه (ألف) من خثعم.
ـ يزيد الحارث بن يزيد بن رويم، معه (ألف) من ذهل الكوفة.
وهذه الأعداد التي ذكرت لهؤلاء ليست على نحو القطع، وإنَّما هناك مجال للبحث والتحقيق، فربما يقلُّ العدد مع بعضهم ويكثر مع البعض الآخر.
ومع هؤلاء القادة (الثلاثة) أو (الخمسة) بإضافة عروة، ويزيد بن الحارث، والأعداد التي أقبلت معهم، أمكن تحديد الخمسة آلاف التي لم يذكرها المؤرخون، ويكتفون بقولهم بعد ذكرهم الخمسة وعشرين ألفاً «وما زال يُرسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده (ثلاثون) ألفاً ما بين فارس وراجل».
وبهذا يكون مجموع جيش ابن زياد الذي ابتدأ منذ اليوم الثاني من المُحرّم، وهو وصول جيش الحرّ بن يزيد الرياحي إلى العاشر منه، هو (ثلاثون) ألفاً.
الأمر الرابع: أسباب كثرة الجيوش الموجّهة إلى كربلاء ودلالة كثرتها
ومنها ما يتعلّق بأعداد الجيوش، فكانت تسعى إلى تقليل العدد الحقيقي الذي وجّه إلى كربلاء؛ لمحاصرة الإمام الحسين×.
ففي (تذكرة) ابن الجوزي: «كان ابن زياد قدْ جهّزَ عمرَ بن سعد بن أبي وقاص لقتالِ الحسين في (أربعة آلاف)، وجهّزَ (خمسمائة فارس)، فنزلوا على الشرايع»[180].
وقد يُقلّل جيش ابن زياد حتى يكون تعداده ألف فارس، كما قال العيني في كتاب المناقب: «كان جيش ابن زياد ألف فارس، رئيسهم الحرّ، وعلى مقدّمتهم الحصين بن نمير»[181].
وكذلك تقليل العدد الذي أقبل مع الحصين بن نمير من أربعة آلاف إلى ألفين، كما في رواية ابن سعد في (طبقاته)، حيث قال: «وعقد عبيد الله لحصين بن تميم الطهوي على ألفين، ووجّهه إلى عمر بن سعد مدداً»[182].
ويقابله تكثير أصحاب الإمام الحسين× حتى جعلتهم في إحدى الروايات «خمسمائة فارس من أهل بيته وأصحابه، ونحو مائة راجل»[183].
حتى يعتقد قارئ تلك الروايات أنَّ المعركة كانت متكافئة من حيث العدد والعدّة، ولا فضل للإمام الحسين× وأصحابه في المنازلة والقتال، وأنَّهم قُتلوا؛ لعجزهم عن القتال، أو لأنَّهم لم يكونوا شجعاناً، كما وصفهم زحر بن قيس حين دخل على يزيد، وقال له: «أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره، ورد علينا الحسين بن علي في ثمانية عشـر من أهل بيته وستين من شيعته، فسـرنا إليهم، فسألناهم أن يستسلموا، أو ينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد، أو القتال، فاختاروا القتال على الاستسلام، فغدونا عليهم مع شروق الشمس، فأحطنا بهم من كلّ ناحية، حتى إذا أخذت السيوف مآخذها من هام القوم، جعلوا يهربون إلى غير وزر، ويلوذون منّا بالآكام والحفر، لواذاً كما لاذ الحمائم من صقر، فو الله يا أمير المؤمنين، ما كانوا إلّا جزر جزور، أو نومة قائل، حتى أتينا على آخرهم، فهاتيك أجسادهم مُجرّدة، وثيابهم مُرمّلة، وخدودهم مُعفّرة، تصهرهم الشمس، وتسفي عليهم الرياح، زوارهم العقبان والرخم»[184].
ويجد القارئ أنَّ الرواية ـ إن صَدَق الرواة أنَّها تُليت أمام يزيد ـ أُحِكمَ إتقانها في اختيار المفردات التي تسـيء إلى منزلة الحسين×، وإبائه وشجاعته، وصلابة أصحابه، ومنها: «فأحطنا، يهربون، يلوذون»، مع رعاية السجع الوارد فيها.
وهكذا الحال بالنسبة لعدد الجيوش، وقد يظنّ القارئ في هذا العدد أنَّه أقرب إلى أن يكون أقل مما ذُكر؛ لذا تطلّب الأمر أن نذكر جملة من الأسباب التي كانت سبباً في كثرة الجيش الأُموي، وأنَّهم (ثلاثون) ألفاً على الأقل.
وعلى كلّ حال نُقدّم فيما يلي تفسيرات كثرة ذلك الجيش:
1ـ احتمال تحوّل الجيوش وتفرّقها
والحكمة من كثرة عدد الجيوش، هي أنَّ السلطة ـ آنذاك ـ احتملت أن تتحول بعض تلك الجيوش للقتال مع الحسين×، فلا بدّ من وجود هذا الاحتمال، وكثرة العدد هي ضمان فيما إذا تحقق هذا الاحتمال.
وكذلك لاحتمال تفرّقها؛ إذ بقي إرسال الجيوش وتسـريبها إلى كربلاء مستمراً إلى اليوم السادس.
وفي بعض الروايات كما تقدّم بقي تسريب الجيوش مستمراً إلى اليوم العاشر؛ وذلك لأنَّ الجيش المرسل إلى كربلاء لا يصل كاملاً، وإنَّما يتفرّق الكثير منهم؛ لئلا يشتركوا في حرب الحسين× وقتاله، ولذلك قال الدينوري: «قالوا: وكان ابن زياد إذا وجّه الرجل إلى قتال الحسين في الجمع الكثير، يصلون إلى كربلاء، ولم يبقَ منهم إلّا القليل، كانوا يكرهون قتال الحسين، فيرتدعون، ويتخلّفون»[185].
ونذكر شاهداً لبعض الأسباب التي جعلت تلك الجموع تكره قتال الحسين، فيرتدعون، ويتخلّفون؛ إذ روى نصر بن مزاحم عن هرثمة بن سليم، قال:
«غزونا مع على بن أبى طالب غزوة صفّين، فلمّا نزلنا بكربلا صلّى بنا صلاةً، فلمّا سلّم رفع إليه من تربتها فشمّها، ثمَّ قال: واها لك أيتها التربة، ليُحشـرن منك قوم يدخلون الجنّة بغير حساب. فلمّا رجع هرثمة من غزوته إلى امرأته ـ وهى جرداء بنت سمير، وكانت شيعة لعلىٍّ ـ فقال لها زوجها هرثمة: ألا أُعجبك من صديقك أبى الحسن! لمّا نزلنا كربلا رفع إليه من تربتها فشمّها وقال: واها لك يا تربة، ليُحشرن منك قوم يدخلون الجنّة بغير حساب، وما علمه بالغيب؟!
فقالت: دعنا منك أيّها الرجل، فإنَّ أمير المؤمنين لم يقل إلّا حقّاً.
فلمّا بعث عبيد الله بن زياد البعث الذي بعثه إلى الحسين بن على وأصحابه، قال: كنت فيهم في الخيل التي بعث إليهم، فلمّا انتهيت إلى القوم، وحسين وأصحابه، عرفت المنزل الذي نزل بنا علىٌّ فيه، والبقعة التي رفع إليه من ترابها، والقول الذي قاله، فكرهت مسيري، فأقْبلت على فرسي حتى وقفت على الحسين، فسلّمت عليه، وحدّثته بالذي سمعت من أبيه في هذا المنزل، فقال الحسين: معنا أنت أو علينا؟
فقلت: يا بن رسول الله، لا معك ولا عليك، تركت أهلي وولْدي أخاف عليهم من ابن زياد. فقال الحسين: فولِّ هرباً حتى لا ترى لنا مقتلاً، فو الذي نفس محمد بيده، لا يرى مقتلنا اليوم رجلٌ ولا يُغيثنا إلّا أدخله الله النار.
قال: فأقبلت في الأرض هارباً حتى خفيَ علىَّ مقتله»[186].
2ـ نكاية بالموالين لأهل البيت^ وإرغامهم على المشاركة
إنَّ إرسال هذا العدد هو سياسة أُمويّة؛ من أجل إرغام كلّ القبائل حتى وإن كانوا كارهين لقتال الحسين×، وإجبارهم على الخروج، لتُذكر أسمائهم فيمَن قاتل الحسين×؛ نكايةً بهم لموالاتهم لأهل البيت^.
3ـ ترهيب المعارضين للحكم الأُموي
إنَّ من أهداف هذا العدد من الجيش الأُموي ـ والذي يُقدّر بثلاثين ألف مقاتل، مع كامل العدّة، وبمختلف صنوف العسكر: من المقاتلين على الخيل بأصنافها، والرجّالة، والرماة، وغيرهم، مقابل ذلك العدد القليل الذي لا يتجاوز المائة، وهو مجموع بني هاشم والأصحاب ـ هو إعلان للأُمّة الإسلاميّة بأنَّ عاقبة كلّ مَن يرفض هذه الدولة تكون له هذه الجيوش بالمرصاد، فهو ترهيب لكلّ المعارضين للحكم الأُموي.
ولكن بالمقابل أيضاً يكون الإمام الحسين× قد رسم موقفاً للأحرار والأُباة، بأنَّ الجهاد لن يُرهب بالأعداد وإن كثُرت، ولن يخاف من العساكر وإن تنوّعت.
إنَّ هذا العدد الكبير من الجيش لا يعني أنَّ الجميع هم من المُحاربين أو الرماة أو غيرهم، من الأصناف القتالية التي يتألف منها، بل هناك قسم كبير كانت لهم أعمال أُخرى، كالذي يعدّ الطعام للجيش، أو تجار السلاح، أو مَن يعمل أوتاداً للخيم، وسككاً ومرابط للخيل، وأسنةً للرماح.
قال السيّد هاشم البحراني: «ورُويَ عن رجل كوفي حداد، قال: لمّا خرج العسكر من الكوفة لحرب الحسين بن علي‘، جمعتُ حديداً كان عندي، وأخذت آلاتي، وسرت معهم، فلمّا وصلوا وطنبوا خيمهم، بنيتُ خيمةً وصرت أعمل أوتاداً للخيم، وسككاً ومرابط للخيل، وأسنةً للرماح، وما أُعوجّ من سنان أو خنجر أو سيف كنت بكلّ ذلك بصيراً، فصار رزقي كثيراً، وشاع ذكري بينهم...»[187].
5ـ الترهيب الأُموي للناس سبب في كثرة الجيش
وهذا الأمر هو أحد أسباب كثرة أهل الكوفة في الجيش الأُموي الخارج لحرب الإمام الحسين×؛ إذ كان تهديدهم بالقتل، أو بهدم الدور، أو السجن، لكلّ مَن رفض المشاركة في الخروج إلى حرب الحسين×.
قال البلاذري: «ووضع ابن زياد المناظر[188] على الكوفة؛ لئلا يجوز أحد من العسكر؛ مخافة لأن يلحق الحسين مغيثاً له، ورتّب المسالح[189] حولها، وجعل على حرس الكوفة زحر بن قيس الجعفي، ورتّب بينه وبين عسكر عمر بن سعد خيلاً مضمرة مقدحة[190] فكان خبر ما قبله يأتيه في كلّ وقت»[191].
وذكر لنا الدينوري صورة من الترهيب الأُموي، فقال: «أمر الناس، فعسكروا بالنُّخيلة، وأمر أن لا يتخلّف أحد منهم... فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب[192]والتجار والسكان إلّا خرج فعسكر معي، فأيّما رجل وجدناه بعد يومنا هذا مُتخلّفاً عن العسكر برئت منه الذمّة»[193].
وقال البلاذري أيضاً: «بعث ابن زياد سويد بن عبد الرحمن المنقري على خيل إلى الكوفة، وأمره أن يطوف بها، فمَن وجده قد تخلّف أتاه به، فبينا هو يطوف في أحياء الكوفة، إذ وجد رجلاً من أهل الشام قد كان قدِم الكوفة في طلب ميراث له، فأرسل به إلى ابن زياد، فأمر به، فضُربت عنقه. فلمّا رأى الناس ذلك خرَجوا»[194].
وهنا ملاحظة مهمّة يجب التذكير بها لأهميتها في كلمة (نداء) في المقدّمة، وهي أنَّ هؤلاء الذي أُخرجوا لحرب الإمام الحسين×، قد يُعتذر لهم ويوجّه خروجهم للقتال لهذه الأسباب، وهو الذي صرّح به عمر بن سعد للإمام الحسين× حينما قال له: «أخاف أن تُهدم داري»[195].
وقد حدثت وقائع كثيرة عبر التاريخ تشبه إلى حدّ كبير واقعة الطفّ في تاريخ الشيعة، ووجّهت مشاركتهم فيها لتلك الأسباب المتقدّمة، وهي (تهديدهم بالقتل، أو بهدم الدور، أو السجن).
وهذه الحوادث يضطرب فيها الناس اضطراباً؛ لأنَّها من الفتن التي يصبح فيها الباطل حقاً، ويُقاتل دونه حتى الموت.
فهل لهذه الأسباب مكانة يمكن أن يعتذر بها الإنسان يوم القيامة؟!
هل كانت تلك الجيوش من الكوفة فقط
قال المسعودي في (مروج الذهب): «وكان جميع مَن حضـر مقتل الحسين من العساكر، وحاربه وتولَى قتله من أهل الكوفة خاصّة، لم يحضرهم شامي»[196].
إنَّ هذه العبارة لا شكّ في تحريفها، وذكر كلمة (خاصّة).
وكذلك قوله: «لم يحضـرها شامي» لها دلالة عميقة؛ إذ الجملة بدونهما كافية وشافية ومغنية.
ولابدّ أن يكون ذكرهما يأتي في مسلسل الموضوعات والأكاذيب التي يراد إلصاقها بأهل الكوفة، وأنَّهم يتحمّلون مسؤولية قتل الإمام الحسين×، وليس بلاد الشام.
وهم بذلك يُريدون الاسم العام للكوفة، وإلّا فالطابع العام لسكنة الكوفة هم من قريش، والعرب الذين قدِموا الكوفة في بداية الفتوحات.
وهنا لا بدّ من التنبيه إلى أنَّ ما ذُكر في (مروج الذهب) عن واقعة كربلاء، ذُكر في عنوانين:
الأوّل: (الحسين يقاتل جيش ابن زياد)، وجاء فيه: «فلمّا بلغ الحسين القادسية لقيه الحرّ بن يزيد التميمي، فقال له: أين تُريد يا بن رسول الله؟
قال: أُريد هذا المصر، فَعَرّفَه بقتل مسلم، وما كان من خبره، ثمَّ قال: ارجع، فإنِّي لم أدَعْ خلفي خيراً أرجوه لك.
فَهَمَّ بالرجوع، فقال له إخوةُ مسلمٍ: والله لا نرجع حتى نُصيب بثأرنا أو نُقتل كلّنا.
فقال الحسين: لا خير في الحياة بعدكم، ثمَّ سار حتى لقي خيل عبيد الله بن زياد عليها عمر بن سعد بن أبي وقاص.
فعدل إلى كربلاء، وهو في مقدار خمسمائة فارس من أهل بيته وأصحابه، ونحو مائة راجل، فلمّا كثرت العساكر على الحسين أيقن أنَّه لا محيص له، فقال: اللهمَّ اُحكم بيننا وبين قوم دَعَوْنَا لينصرونا، ثمَّ هم يقتلوننا. فلم يزل يقاتل حتى قُتل (رضوان الله عليه).
وكان الذي تولى قتله رجل من مذْحج، واحتزّ رأسه، وانطلق به إلى ابن زياد، وهو يرتجز:
|
أوقر ركابي فِضّة وذَهَبَا |
|
أنا قتلتُ الملك المحجَّبَا |
|
قتلتُ خَيْرَ الناس أُمّاً وأباً |
|
وَخَيْرَهُم إذ يُنْسَبُونَ نسبا»[197]. |
وأمّا العنوان الثاني هو: (مَن قُتل مع الحسين)
وجاء فيه: «فبعث به ابن زياد إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس، فدخل إلى يزيد وعنده أبو بَرْزَه الأسلمي، فوضع الرأس بين يديه، فأقبل ينكت القضيب في فيه، ويقول:
|
نُفَلِّـقُ هَـاماً
من رجالٍ أحبّة |
|
عَلَيْنَا، وهم
كانوا أعقّ وأظلما |
فقال له أبو بَرْزَة: ارفع قضيبك فطال ـ والله ـ ما رأيت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، يضع فمه علىِ فمه يلثمه، وكان جميع مَن حضـر مقتل الحسين من العساكر وحاربه وتولّى قتله من أهل الكوفة خاصّة، لم يحضرهم شامي.
وكان جميع مَن قُتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانين، منهم ابنه علي بن الحسين الأكبر، وكان يرتجز ويقول:
أنا عليُّ بنُ الحسينِ بن علي نَحْنُ وبيت الله أوْلى بِالنبِي
تالله لا يَحْكُمُ فِينَا ابنُ الدَّعِي»[198].
ثمَّ ذكر المسعودي بقية مَن قُتل من بني هاشم.
وما ورد في النصّ الأوّل يدلّ على تحريفه وتغييره، وإضافة مسائل هي خلاف ما أجمع عليه المؤرخون.
ومنها أنَّه «سار حتى لقي خيل عبيد الله بن زياد عليها عمر بن سعد بن أبي وقاص، فعدل إلى كربلاء».
وكذلك ما ورد في عدد مَن كان معه: «وهو في مقدار خمسمائة فارس من أهل بيته، وأصحابه، ونحو مائة راجل».
وكذلك في المحاورة التي ذُكرت بينه وبين الحرّ بن يزيد، وانتهت بأنَّ الإمام الحسين× (همّ بالرجوع)، وأنَّه لا رأي له في اتخاذ المواقف، حتى أنَّه استجاب لإخوة مسلم من أجل أن يأخذوا بثأرهم، وكأنَّ المسألة أضحت شخصية.
بينما الصحيح هو قوله× في يوم عاشوراء لعمر بن سعد: «... فعلمت غرور ما كتبوا به إليّ، أردت الانصراف إلى حيث منه أقبلت، فمنعني الحرّ بن يزيد، وسار حتى جعجع بي في هذا المكان... »[199].
فالرواية أُموية الوضع، وهي تُريد أن تُصوّر الإمام الحسين× رجلاً عادياً يتأثر بمَن حوله.
ولا شكّ أنَّ هذه المسائل تدلّل على أنَّ هذا النصّ مُحرّف.
والتحريف هذا يذكّر بتلك التحريفات التي طالت النصوص الكثيرة، التي ذُكرت في واقعة كربلاء؛ من أجل إثارة الشبهات حول شخصيات الثورة الحسينيّة.
ومنها كما زعموا أنَّ الحسين طلب منهم أن يمضي إلى يزيد، وأن يرى فيه رأيه، أو يضع يده بيده.
ومن الغريب أنَّ ابن نما الحلي اعتمد في مقتله[200]على هذه الرواية، وأثبتها فيه.
ولا شكّ أنَّ هذا العرض الذي نُسب للإمام الحسين× مكذوبٌ عليه، وهو من وضع السياسة الأُمويّة، وهو يخالف ما ذكره عقبة بن سمعان ـ وهو شاهد عيان، وفي موقع يتيح له الاطّلاع التام على حقيقة المحاورات والأحداث والمواقف ـ حيث قال: «صحبت حسيناً، فخرجت معه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، ولم أفارقه حتى قُتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة، ولا في الطريق ولا بالعراق، ولا في عسكر، إلى يوم مقتله إلّا وقد سمعتها، لا والله، ما أعطاهم ما يتذاكر الناس، وما يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية، ولا أن يُسيّروه إلى ثغر من ثغور المسلمين، ولكنّه قال: دعوني فـلأذهب في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس»[201].
والغاية منها تشويه صورة الإمام الحسين× في أذهان المسلمين.
وكذلك أرادوا تشويه صورة أخيه العباس في رواياتهم بعد تحريف كلامه مع إخوته، حينما طلب منهم أن يبرزوا للقتال. ففي تاريخ الطبري: «قال: وزعموا أنَّ العباس بن علي قال لإخوته من أُمّه، عبد الله، وجعفر، وعثمان: يا بني أُمّي، تقدّموا حتى أرثكم، فإنَّه لا ولد لكم»[202].
ولم يقتنع الراوي بهذا الرأي في كلمة (وزعموا).
ولكن ابن الأثير الذي ـ اعتمد على الطبري ـ حذف هذا التضعيف وأرسله إرسال المسلمات، فقال: «وقال العباس بن علي لإخوته من أُمّه عبد الله، وجعفر، وعثمان، تقدّموا حتّى أرثكم؛ فإنَّه لا ولد لكم، ففعلوا، فقتلوا»[203].
والصحيح في الرواية ما ذكره الدينوري، قال: «قالوا: ولمّا رأى ذلك العباس بن علي، قال لإخوته عبد الله، وجعفر، وعثمان، بني علي (عليه وعليهم السلام)، وأُمّهم جميعاً أُمّ البنين العامرية من آل الوحيد: تقدّموا بنفسي أنتم، فحاموا عن سيّدكم حتى تموتوا دونه. فتقدّموا جميعاً. فصاروا أمام الحسين×، يقونه بوجوههم ونحورهم»[204].
أقول: أردت من هذين المثالين التأكيد على أنَّ ما ورد في (مروج الذهب) له نصيب من التحريف.
وقد يكون هناك مجال لتأويل رواية المسعودي: «وكان جميع مَن حضـر مقتل الحسين من العساكر، وحاربه وتولى قتله من أهل الكوفة خاصّة، لم يحضـرهم شامي»، وهو: أن يكون مراده أنَّ الجيوش التي حضرت المعركة هي من الكوفة، أي: من القواعد العسكرية؛ لأنَّها كانت مكاناً تتجمع فيه العساكر، ثمَّ يكون انطلاقها نحو أهدافها، وحينئذٍ يكون كلامه صحيحاً.
وأمّا إن كان مراده جميع مَن حضر من أهل الكوفة خاصّة، فهو غير صحيح؛ لأنَّ هذه الجيوش ليست من الكوفة فقط، بل قدِم بعضهم من أمصار أُخرى؛ لأنَّ الكوفة أصبحت قاعدة لتجميع الجيوش من مختلف البلاد الإسلاميّة، ومنها تنطلق إلى البلدان الأُخرى، كما رأينا خاصّة الجيش الذي كان مع عمر بن سعد وأُعدّ لـ(دستبى)، فهو خليط من جميع الأمصار وليس من الكوفة، وممّن اشترك في جيش عبيد الله من غير أهل الكوفة:
1ـ البصرة، إذ نجد بعض المؤرّخين يذكرون أنَّ سمرة كان يحرّض على قتل الحسين في البصرة، حين جاء عبيد الله إلى الكوفة وعيّنه والياً على البصرة.
وفي شرح النهج: «إنَّ سمرة هو الذي كان يحرّض الناس لحرب الحسين×، وكان نائباً عن ابن زياد في البصرة عند مجيئه إلى الكوفة، وهو... من المُنحرفين عن أمير المؤمنين×»[205].
ويضاف إلى ذلك أنَّ واقعة كربلاء لا تختلف عمّا سبقها من الوقائع، فقد اشتركت في صفّين قبائل كثيرة من البصرة.
ومنها: بكر البصرة وعليهم حضين بن المنذر، وتميم البصـرة وعليهم الأحنف بن قيس وسعد، ورباب البصـرة وعليهم جارية بن قدامة السعدي وعمرو، وحنظلة البصرة وعليهم أعين بن ضبيعة، وذهل البصـرة وعليهم خالد بن المعمر السدوسي، وعبد القيس البصرة وعليهم عمرو بن حنظلة، وقريش البصـرة وعليهم الحارث بن نوفل الهاشمي، وقيس البصرة وعليهم قبيصة بن شداد الهلالي.
وكذلك وجد مجموعة في صفّين يصطلح عليها بـ(القواصي)، وهم من أماكن بعيدة لم تنتظم ضمن قبيلة، فقالوا: وعلى اللفيف من القواصي القاسم بن حنظلة الجهني.
وهذا مثال لمِا كان عليه الحال في صفّين، وهو لن يتغيّر كثيراً في واقعة كربلاء، فوجب أن يكون الكثير ممّن حضر الواقعة هم ليسوا جميعاً من أهل الكوفة.
2ـ الشام، وذكرتهم رواية ابن شهر آشوب: «وجهّز ابن زياد خمساً وثلاثين ألفاً... وشمر بن ذي الجوشن السلولي في أربعة آلاف من أهل الشام»[206].
ولعلّ ابن شهر آشوب اعتمد في هذا الرأي على ما ذكره ابن أعثم في كتاب الفتوح، فقد ذكر أنَّ ابن زياد جمع الناس إلى حرب الحسين×، وخطبهم في الكوفة، وبعد خطبته نزل عن المنبر ووضع لأهل الشام العطاء، فأعطاهم ونادى فيهم بالخروج إلى عمر بن سعد؛ ليكونوا أعواناً له على قتال الحسين.
وهذا يدلّ على أنَّ الكثير من جند أهل الشام كانوا في الكوفة، فقال: «ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي (رضي الله عنه).
قال: ثمَّ جمع عبيد الله بن زياد الناس إلى مسجد الكوفة، ثمَّ خرج فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال: أيَّها الناس، إنَّكم قد بلوتم آل سفيان، فوجدتموهم على ما تُحبون، وهذا يزيد قد عرفتموه، أنَّه حسن السيرة، محمود الطريقة، محسن إلى الرعية، متعاهد الثغور، يُعطي العطاء في حقّه، حتى أنَّه كان أبوه كذلك، وقد زاد أمير المؤمنين في إكرامكم، وكتب إليَّ يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار ومائتي ألف درهم أفرّقها عليكم، وأخرجكم إلى حرب عدوه الحسين بن علي، فاسمعوا له وأطيعوا، والسلام.
قال: ثمَّ نزل عن المنبر، ووضع لأهل الشام العطاء، فأعطاهم ونادى فيهم بالخروج إلى عمر بن سعد؛ ليكونوا أعواناً له على قتال الحسين.
قال: فأوّل مَن خرج إلى عمر بن سعد، الشمر بن ذي الجوشن السلولي (لعنه الله) في أربعة آلاف فارس، فصار عمر بن سعد في تسعة آلاف...»[207].
وحدد ابن شهر آشوب قائد أهل الشام، هو الشمر بن ذي الجوشن السلولي؛ وذلك لأنَّ عبيد الله ابتدأ بوضع العطاء لأهل الشام، ثمَّ هم أوّل مَن نادى بهم للخروج إلى عمر بن سعد؛ ليكونوا أعواناً له على قتال الحسين×، وبما أنَّ أوّل مَن خرج هو شمر بن ذي الجوشن، فكانوا هم أوّل مَن التحق بهم.
ولكن لا يمكن الاعتماد على قوله في عددهم؛ إذ قال: «وشمر بن ذي الجوشن السلولي في أربعة آلاف من أهل الشام»، بينما في الروايات الأُخرى أنَّ شمراً جاء مع هوازن من الكوفة.
وعلى ما تقدّم من تقسيم البعوث الذين كانوا على شكل (آلاف)، أي: على كلّ (ألف) قائد عسكري، فهنا لا بدّ أن يكون معه على أقل تقدير (ألف) من هوازن، فتكون عدّة أهل الشام (ثلاثة آلاف).
وقد ورد ذكر دور لبعض الأُسر التي تسكن الشام في واقعة كربلاء، في كتاب (التعجب) للكراجكي المتوفى سنة (449هـ)، «ومنهم في أرض الشام: (بنو السـراويل، وبنو السـرج، وبنو سنان، وبنو الملحي، وبنو الطشتي، وبنو القضيبي، وبنو الدرجي)، وسنذكر تفصيل ما ذكره المؤلف لأهمية بعض العناوين التي وردت فيه، فقال: ومن عجيب ما سمعتُه: أنَّهم في المغرب بمدينة قرطبة يأخذون في ليلة العاشوراء رأس بقرة ميتة، ويجعلونه على عصا، ويُحمل ويُطاف به الشوارع والأسواق، وقد اجتمع حوله الصبيان يُصفّقون ويلعبون، ويقفون به على أبواب البيوت، ويقولون: يا مسـي المروسة، أطعمينا المطنفسة ـ يعنون القطائف ـ وأنَّها تُعدّ لهم، ويُكرمون ويتبركون بما يفعلون.
وحدّثني شيخ بالقاهرة من أهل المغرب كان يخدم القاضي أبا سعيد ابن العارفي&، أنَّه كان ممّن يحمل هذا الرأس في المغرب، وهو صبي في ليلة عاشوراء، فرأى هذا من فرط المحبّة لأهل البيت^، وشدّة التفضيل لهم على الأنام.
وقد سمع هذه الحكاية بعض المتعصبين لهم، فتعجب منها وأنكرها، وقال: ما يستجيز مؤمن أن يفعلها. فقلت: أعجب منها حمل رأس الحسين بن علي بن أبي طالب× على رمح عال، وخلفه زين العابدين× مغلول اليدين إلى عنقه، ونساؤه وحريمه معه سبايا مُهتّكات على أقتاب الجمال، يُطاف بهم البلدان، ويُدخل بهم الأمصار التي أهلها يُظهرون الإقرار بالشهادتين، ويقولون: إنَّهم من المسلمين، وليس فيهم مُنكر، ولا أحد ينفر، ولم يزالوا بهم كذلك إلى دمشق، وفاعلو ذلك يُظهرون الإسلام، ويقرؤون القرآن، ليس منهم إلّا مَن قد تكرر سماعه قول الله سُبحانه: ( ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ) [208]، فهذا أعظم من حمل رأس بقرة في بلدة واحدة.
ومن عجيب قولهم: إنَّ أحداً لم يشـر بهذا الحال، ويستبشـر بما جرى فيها من الفعال، وقد رأوا ما جرى، قرره شيوخهم، ورسمه سلفهم، من تبجيل كلّ مَن نال من الحسين (صلوات الله عليه) في ذلك اليوم منالاً، وآثر في القتل به أثراً، وتعظيمهم لهم، وجعلوا ما فعلوه سمة لأولادهم.
فمنهم في أرض الشام: (بنو السراويل، وبنو السـرج، وبنو سنان، وبنو الملحي، وبنو الطشتي، وبنو القضيبي، وبنو الدرجي).
وأمّا بنو السراويل: فأولاد الذي سلب سراويل الحسين×.
وأمّا بنو السرج: فأولاد الذين أُسرجت خيله لدوس جسد الحسين×، ووصل بعض هذه الخيل إلى مصر، فقلعت نعالها من حوافرها وسُمّرت على أبواب الدور ليُتبرك بها، وجرت بذلك السنّة عندهم حتى صاروا يتعمدون عمل نظيرها على أبواب دور أكثرهم.
وأمّا بنو سنان: فأولاد الذي حمل الرمح الذي على سنانه رأس الحسين×.
وأمّا بنو المكبري: فأولاد الذي كان يُكبر خلف رأس الحسين×، وفي ذلك يقول الشاعر[209]:
|
ويُكبرون بأن قُتلت
وإنَّما |
|
قتلوا بك
التكبير والتهليلا |
وأمّا بنو الطشتي: فأولاد الذي حمل الطشت الذي تُرك فيه رأس الحسين×، وهم بدمشق مع بني الملحي معروفون.
وأمّا بنو القضيبي: فأولاد الذي أحضرَ القضيب إلى يزيد (لعنه الله)؛ لنكت ثنايا الحسين×.
وأمّا بنو الدرجي: فأولاد الذي ترك الرأس في درج جيرون[210].
وهذا لعمرك هو الفخر باب من أبواب دمشق إلى الواضح، لولا أنَّه فاضح.
وقد بلغنا أن رجلاً قال لزين العابدين×: إنّا لنحبكم أهل البيت. فقال×: أنتم تحبونا حبّ السنّورة[211] من شدّة حبّها لولدها تأكله. أترى هذا عن محبّة ومصافاة، وخالص مودّة وموالاة؟
ألم يروا ما فُعل قبل ذلك من لعن أمير المؤمنين× على المنابر ثمانين سنة، ليس فيها مسلم ينكر، حتى أنَّ أحد خطبائهم بمصر، نسي أن يلعن أمير المؤمنين× على المنبر في خطبته، وذكر ذلك في الطريق عند مُنصرفه، فلعنه حيثُ ذكر قضاءً لمِا نسيه، وقياماً بما يرى أنَّه فرضٌ.
وقد لزم وبُنىَ في ذلك المكان مسجداً، وهو باقٍ إلى الآن بسوق وردان[212] يُعرف بـ (مسجد الذكر)، وهُدم في بعض السنين لأمر من الأُمور، فرأيتُ في موضعه سُرُجاً كثيرة، وآثارَ بخور لنذور.
وقيل لي: إنَّه يُؤخذ من ترابه ويُتشافى به، ثمَّ بُنيَ بعد ذلك وعَظُم أمره.
وفي مسجد الرمح أيضاً، خبرٌ عجيبٌ يعرفه مَن افتقد أسرار القوم، لهم الويل الطويل، والعذاب النكيل.
لقد نبذوا قدسهم[213]، وأطفأوا نيرانهم، واحتقبوا العظائم، واستفرهوا المخاصم. وقد بلغنا أنَّ أمير المؤمنين×، قال: (أنا أوّل مَن يجثو يوم القيامة للخصوم)»[214].
3ـ لا شكّ في وجود الموالي والمماليك والمتطوعين في جيش عمر بن سعد من غير أهل الكوفة.
وقد يقال: إنَّ الأربعة آلاف الذين قدِموا مع عمر بن سعد، هم جميعاً من الفرس أو بعضهم، ويُستدل على وجودهم في الكوفة بحديث مسعر بن كدام، قال: «كان مع رستم يوم القادسية أربعة آلاف، يُسمّون جند شهانشاه. فاستأمنوا على أن ينزلوا حيث أحبّوا، ويحالفوا مَن أحبّوا، ويُفرض لهم في العطاء، فأُعطوا الذي سألوه... وكان لهم نقيب منهم يقال له ديلم، فقيل: حمراء ديلم.
ثمَّ إنَّ زياداً سيّر بعضهم إلى بلاد الشام بأمر معاوية، فهم بها يدعون الفرس»[215].
ولعلّ البعض الآخر سكن الكوفة، واشترك قسم منهم مع جيش عمر بن سعد، ولم أعثر على نصّ صريح بوجود كثرة واضحة منهم، أو في تسمية أحد منهم في قادة العسكر، أو اشتهر صنف من أصناف الجيش بهم، كالرماة، والرجّالة، والخيّالة، وغيرهم.
والمؤكد أنَّ الجيش الذي قدِم مع عمر بن سعد لم يكن من أهل الكوفة خاصّة، وإن كان قادته من رؤساء قبائل الكوفة؛ لأنَّ المتعارف عليه آنذاك في مثل هذا الجيش الذي يُعدّ للغزوات، أو للدفاع عن البلاد الإسلاميّة، يكون تعداده من أمصار مختلفة، ونذكر لذلك مثالاً من سنة (98هـ) حين غزا يزيد بن المهلب جرجان، يقول المؤرخون: «فأقام عليها، وحاصر أهلها، معه أهل الكوفة، وأهل البصـرة، وأهل الشام، ووجوه أهل خراسان والري، وهو في مائة ألف مقاتل سوى الموالى والمماليك والمتطوعين»[216].
الأمر الخامس: طلب المؤلف من السائل التحقيق في عدد القبائل
لقد ختم السيّد حسن الصدر+ جوابه في هذه الرسالة، بطلبه من السائل أن يُكمل التحقيق في عدد القبائل التي أُخرجت إلى حرب الإمام الحسين×؛ إذ يمكن معرفة عدد الجيش الأُموي الذي اشترك في المعركة، فقال: «وليكن بهذا كفاية لسيّدنا الأجل (أدام الله سُبحانه تأييده)، فقد فُتِح له باب تحقيق الحقّ في هذا الباب، فعليه (أدام الله توفيقه) أن يبحث عن عدد العشائر والطوائف المذكورة، وسائر الدلائل والإشارات التي جمعتها له».
وأشار السيّد الصدر+ إلى مثالين:
المثال الأوّل: فيما نقله عن الطبري استشهاداً لتسمية بعض القبائل التي بعثها عبيد الله بن زياد، بعد بعث عمر بن سعد إلى كربلاء في قوله: «إنَّ عمر بن سعد جعل على ربع أهل المدينة عبد الله بن زهير الأزدي، وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن أبي سبره الحنفي (الجعفي)، وعلى ربع تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الرياحي.
ثمَّ قال: وجعل على ميمنته الحجاج الزبيدي، وعلى ميسـرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس الأحمسي، وعلى الرجّالة شبث بن ربعي التميمي».
المثال الثاني: في قوله: «فإنِّي لا أنسى أنَّ كندة اثنا عشـر ألفاً يوم صفّين، ولا يحضـر ببالي باقي عدد العشائر...»
وأمّا بالنسبة للأمر الأوّل ـ وهو في تسمية بعض القبائل، وقد اعتمد على رواية الطبري في تقسيم القبائل والقادة ـ فقد قسّم الأُستاذ أحمد حسين يعقوب القادة على صنفين: فمنهم مَن كان قائداً للجند الذين لم ينضووا تحت لواء قبيلة، وصنف آخر قادة لقبائلهم، قال: «من أركان القيادة... الذين... لعبوا دوراً بارزاً في قيادة الجند، الذين اشتركوا بمذبحة كربلاء. نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: الحصين بن تميم التميمي، وشبث بن ربعي، وكعب بن طلحة، وحجار بن أبجر، ونصـر بن حرشة، ومضاير بن رهينة.
ومن الذين قادوا قبائلهم: قيس بن الأشعث، وهلال بن الأعور، وغيهمة بن أبي زهير، والوليد بن عمرو.
القبائل التي اشتركت بالمذبحة:
نذكر منها على سبيل المثال:
1ـ كندة، 2ـ هوازن، 3ـ تميم، 4ـ بنو أسد، 5ـ مذحج، 6ـ الأزد، 7ـ ثقيف)»[217].
و(الأزد وثقيف) على رواية الدينوري.
وهناك إحصاء أيضاً تُعرف به بعض القبائل، من خلال حملهم الرؤوس بعد واقعة الطفّ، وفصّل الحديث فيه الشيخ محمد مهدي شمس الدين، فليراجع[218].
وشهرة هذه القبائل في كتب التاريخ لكثرة مَن اشترك منها في الحرب والقتال، ولمجيئها بأكثر عدد من رؤوس القتلى، ولدورها المؤثر في الأحداث التي حصلت في الكوفة، وهناك أفراد من قبائل أُخرى عُرفوا من خلال أسمائهم وألقابهم كما جاء في كتب المقاتل.
وكذلك يدلّل على ذلك أنَّ مجموعة من القبائل لم تُذكر أسماؤهم، وهي التي جاءت بمجموعة من الرؤوس، فقالوا: «وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤس»، أي: إنَّ هناك قبائل أُخرى أقبلت بهذه الرؤوس غير التي تقدّمت.
ويُذكر أنَّ اختلافات شديدة حصلت في الجيش الأُموي على هذه الغنائم (رؤوس القتلى).
وفي رواية الطبري عن مقتل عابس بن شبيب الشاكري: «إنَّهم تعطّفوا عليه من كلّ جانب، فقُتل، قال: فرأيت رأسه في أيدي رجال ذوي عدّة، هذا يقول أنا قتلته، وهذا يقول أنا قتلته، فأتوا عمر بن سعد، فقال: لا تختصموا هذا لم يقتله سنان واحد، ففرّق بينهم بهذا القول»[219].
وفي مقتل حبيب بن مظاهر: «إنَّ رجلاً من بنى تميم حمل عليه، فضربه بالسيف على رأسه فقتله، وحمل عليه آخر من بنى تميم، فطعنه فوقع، فذهب ليقوم فضـربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف فوقع، ونزل إليه التميمي فاحتزّ رأسه، فقال له الحصين: إنِّي لشـريكك في قتله. فقال الآخر: والله ما قتله غيري. فقال الحصين: أعطنيه أُعلّقه في عنق فرسي كيما يرى الناس ويعلموا أنِّى شركت في قتله، ثمَّ خُذْه أنت بعدُ، فامض به إلى عبيد الله بن زياد، فلا حاجة لي فيما تُعطاه على قتلك إيّاه. قال: فأبى عليه، فأصلح قومه فيما بينهما على هذا»[220].
تسمية بعض القبائل التي اشتركت في وقعة صفّين
وأمّا عن الأمر الثاني، وهو في إشارة السيّد حسن الصدر+ إلى مراجعة عدد القبائل التي اشتركت في واقعة صفّين؛ إذ يمكن من خلال ذلك التوصل إلى معرفة عدد الجيوش التي أُخرجت إلى حرب الإمام الحسين×، فقال: «فمَن أراد الوقوف على الحقائق أخذ بما جمع ما جاء في هذا الباب، وأمعن النظر فيه، وأعطى كلّ كلام حقّه، فإنِّي لا أنسى أنَّ كندة اثنا عشر ألفاً يوم صفّين[221]. ولا يحضر ببالي باقي عدد العشائر...».
ونذكر عن ذلك ثلاث مسائل:
الأُولى: في تسمية بعض القبائل التي عقد لها الإمام علي الألوية وكتّبها، ومَن استعمل عليها، وجاء في وقعة صفّين: «إنَّ علياً×، ومعاوية، عقدا الألوية، وأمّرا الأُمراء، وكتّبا الكتائب، واستعمل على الخيل عمار بن ياسر، وعلى الرجّالة عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي، ودفع اللواء إلى هاشم بن عتبة ابن أبي وقاص الزهري، وجعل على الميمنة الأشعث بن قيس، وعلى الميسرة عبد الله بن العباس، وجعل على رجّالة الميمنة سُليمان بن صرد الخزاعي، وجعل على رجّالة الميسرة الحارث بن مرّة العبدي، وجعل القلب مضـر الكوفة والبصرة، وجعل الميمنة اليمن، وجعل الميسرة ربيعة. وعقد ألوية القبائل فأعطاها قوماً منهم بأعيانهم، جعلهم رؤساءهم وأمراءهم، وجعل على قريش وأسد وكنانة عبد الله بن عباس، وعلى كندة حجر بن عدي، وعلى بكر البصرة حضين بن المنذر. وعلى تميم البصرة الأحنف بن قيس، وعلى خزاعة عمرو بن الحمق، وعلى بكر الكوفة نعيم بن هبيرة، وعلى سعد ورباب البصـرة جارية بن قدامة السعدي، وعلى بجيلة رفاعة بن شداد، وعلى ذهل الكوفة يزيد بن رويم الشيباني، وعلى عمرو وحنظلة البصرة أعين بن ضبيعة، وعلى قضاعة وطيء عدي بن حاتم، وعلى لهازم الكوفة عبد الله بن حجل العجلي. وعلى تميم الكوفة عمير بن عطارد، وعلى الأزد واليمن جندب بن زهير، وعلى ذهل البصرة خالد بن المعمر السدوسي، وعلى عمرو وحنظلة الكوفة شبث بن ربعي، وعلى همدان سعيد بن قيس، وعلى لهازم البصرة حريث بن جابر الحنفي، وعلى سعد ورباب الكوفة الطفيل أبا صريمة، وعلى مذحج الأشتر بن الحارث النخعي، وعلى عبد القيس الكوفة صعصعة بن صوحان، وعلى قيس الكوفة عبد الله بن الطفيل البكائي، وعلى عبد القيس البصـرة عمرو بن حنظلة، وعلى قريش البصـرة الحارث بن نوفل الهاشمي، وعلى قيس البصرة قبيصة بن شداد الهلالي، وعلى اللفيف من القواصي القاسم بن حنظلة الجهني»[222].
نماذج من عدد القبائل التي اشتركت في وقعة صفّين
الثانية: في ذكر نماذج من عدد القبائل التي اشتركت في وقعة صفّين من كتاب نصـر بن مزاحم: «إنَّ علياً حين أراد المسير إلى النُّخيلة دعا زياد بن النضـر، وشريح بن هانئ، وكانا على مذحج والأشعريين... وبعثهما في اثني عشر ألفاً»[223].
«إنَّ علياً بعث من المدائن معقل بن قيس الرياحي في ثلاثة آلاف رجل»[224].
«أمر الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف فارس»[225].
«كان بصفّين أربعة آلاف محجف من عنزة، والمحجف: لابس الحجفة، وهى ترس يُتخذ من جلود الإبل»[226].
«بلغ عليا أنَّ عبيد الله بن عمر قد توجّه ليأتيه من ورائه، فبعث إليهم أعداداً ليس منهم إلّا تميمي»[227].
«وركب× فرسه الذي كان لرسول الله... ثمَّ نادى: مَن يشـرِ نفسه لله... فانتدب له ما بين عشرة آلاف إلى اثني عشـر ألفاً [قد] وضعوا سيوفهم على عواتقهم»[228].
«أُصيب في المبارزة من أصحاب على زهاء عشرة آلاف... وأُصيب يوم الوقعة العظمى أكثر من ذلك، وأُصيب فيها من أصحاب على ما بين السبعمائة إلى الألف»[229].
«كتب معاوية إلى زياد بن سُمية كتاباً... كان وعيداً وتهدداً، فقال زياد: ويلي على معاوية ابن آكالة الأكباد، وكهف المنافقين وبقية الأحزاب، يتهددني ويوعدني وبيني وبينه ابن عمّ محمد، ومعه (سبعون ألفاً) طوائع»[230].
«ثلاث قبائل لم يكن لأهل العراق قبائل أكثر منها عدداً يومئذٍ: على ربيعة، وهمدان، ومذحج»[231].
«قيل لعلي: أيّ القبائل وجدت أشدّ حرباً بصفّين؟ قال: الشعر الأذرع من همدان، والزرق العيون من شيبان»[232].
ولا شكّ أنَّ كثيراً من أفراد هذه القبائل التي اشتركت في صفّين قد تغيّر ولاؤها بعد سيطرة معاوية على الحكم، وبما فعله من سياسة الترهيب والترغيب، ولم يقتصر هذا الأمر على عموم الناس، بل حتى قادة القبائل والعساكر بعد أن كانوا في وقعة صفّين إلى جانب الإمام علي×، رأيناهم يقودون قبائلهم لحرب الحسين×.
ومن قادة القبائل على سبيل المثال: الأشعث بن قيس، ومن قادة العساكر شبث بن ربعي، وكلامه مشهور في وقعة كربلاء، حيث قال: «لا يُعطى الله أهل هذا المصـر خيراً أبداً، ولا يُسدّدهم لرشد، ألا تعجبون أنا قاتلنا مع علي بن أبي طالب، ومع ابنه من بعده آل أبي سفيان خمس سنين، ثمَّ عَدَونا على ابنه، وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سمية الزانية، ضلال يا لك من ضلال!»[233]. وبما تقدّم استطاع عبيد الله بن زياد أن يعدّ جيشاً يكون تعداده أكثر من (ثلاثين ألفاً) أو أكثر، من خلال ما تقدّم ذكره من أسماء القبائل التي اشتركت في صفّين وأعدادها، والتي تغيّر ولاؤها وأصبح للحكم الأُموي.
الثالثة: في البحث عن عدد العشائر والطوائف في الكوفة[234].
وهنا لا بدّ من تعريف مصطلح (الربع) الذي ورد في الروايات كقوله: «كان على ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الحنفي، وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى ربع تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الرياحي...».
ومصطلح (الربع)[235] أو (الخمس) يتعلّق بالتقسيم الإداري لبعض المدن والأمصار، وعلى سبيل المثال: كانت البصـرة مُقسّمة في عهد الإمام الحسين على خمسة أخماس، وهي:
ـ العالية، سيّدها قيس بن الهيثم (بفتح هاء هيثم، وسكون الياء المثناة تحت، وبالثاء المثلثة) بن أسماء بن الصلت السلمي.
ـ بكر بن وائل، سيّدها مالك بن مسمع (بوزن منبر) البكري سيّد بكر بن وائل.
ـ تميم، سيّدها الأحنف بن قيس ـ المشهور بالحلم ـ التميمي.
ـ عبد قيس... المنذر بن الجارود العبدي سيّد عبد قيس
ـ الأزد مسعود بن عمر الأزدي الفهمي سيّد الأزد
وأمّا الكوفة فكان تقسيمها على أرباع، هو التقسيم الثاني لها.
وكان التقسيم الأوّل للكوفة على قسمين أو نصفين، فخطّ سعد بن أبي وقاص سهم أهل اليمن في الجانب الشرقي، وصارت خطط نزار في الجانب الغربي[236].
وأمّا عددهم حين نزولهم سنة ثمانية عشـر للهجرة حين تمصير الكوفة، فذكره الشعبي، فقال: كنّا ـ يعنى أهل اليمن ـ اثنى عشر ألفاً.
وكانت نزار ثمانية آلاف. وبقي معهم أربعة آلاف من الجنود الفرس، قال عنهم مسعر بن كدام: كان مع رستم يوم القادسية أربعة آلاف يُسمّون جند شهانشاه.
فاستأمنوا على أن ينزلوا حيث أحبّوا، ويحالفوا مَن أحبّوا، ويفرض لهم في العطاء، فأُعطوا الذي سألوه...
وكان لهم نقيب منهم يقال له (ديلم)، فقيل: حمراء ديلم.
ثمَّ إنَّ زياداً سَيّر بعضهم إلى بلاد الشام بأمر معاوية، فهم بها يُدعَون: الفرس.
ووضّحَ تفصيل ذلك الشيخ علي الشرقي[237]، فيما نشره في مجلة الاعتدال النجفية،
تحت عنوان عروبة المتنبي، فقال: «مُصّـرت الكوفة في العام السابع عشـر للهجرة، وتكاملت كمدينة أكواخ في خمس سنوات... وقد قُسّمت إدارتها إلى أرباع، على كلّ ربع زعيم يقوم بإدارته، أمّا تقسيمها من حيث التخطيط، فكان ذلك المخيم الواسع موزعاً توزيعاً عسكرياً يتألف من سبعة أفواج، كلّ فوج يضمّ قسماً من محلاتها المعروفة باسم قبائلها، ولم تكن في الكوفة أوّلاً شوارع، بل كانت خليطاً من تجمعات سبع، كلّ مجموعة من عدّة عشائر تنزل في جهة...
الأوّل: كنانة وحلفاؤها، وجديلة، وقد كانت هذه القبائل سناد العامل في الكوفة من زمن سعد إلى العهد الأُموي، وهم المعروفون بأهل العالية، كان لهم العدد الأوفر ولكنّه أخذ يتضاءل تدريجياً.
والقسم الثاني: قضاعة، وبجيلة، وغسان، وخثعم، وكندة، وحضرموت، والأزد.
الثالث: مذحج، وحمير، وهمدان، وقد لعب هذا القسم دوره في حوادث الكوفة، وكانت له المواقف البارزة.
الرابع: تميم، ورباب.
الخامس: بنو أسد، ومحارب، ونمر من بني بكر، وتغلب، وأكثرية هؤلاء من ربيعة.
والسادس: إياد، وبنو عبد قيس، وأهل هجر، والحمر.
والأوّلان من هذا القسم بقية قبائل كانت تقيم هناك من السابق.
أمّا بنو عبد القيس، فقد هبطوا من البحرين تحت زعامة زهرة بن حوية.
وقد كان الحمر حلفاء زهرة وينزلون معه، وهؤلاء الحمر عدتهم أربعة آلاف جندي فارسي يُسمون جند شاهنشاه، كما ذكر البلاذري: استأمنوا يوم القادسية على أن ينزلوا حيث أحبوا ويخالفوا مَن أحبّوا، ويُفرض لهم في العطاء.
فأُعطوا الذي سألوه، وكان لهم نقيب يقال له: ديلم، فقيل لهم: حمراء ديلم»[238].
«ولمّا جاء عهد زياد فرّقهم في الشام والبصـرة والكوفة، وكان لهذا القسم السادس دور ثقافي في الكوفة والبصرة.
السابع: مُلَمْلَمة، أظهرهم طي.
وقد غيّر الإمام علي× تشكيل هذه التجمعات عندما تولى قيادة الكوفيين، فكانت:
أوّلاً: همدان، وحمير، والحمر.
ثانياً: مذحج، وأشعر، وطيء، والعَلَمُ في هذا القسم يحمله نصر بن مزاحم.
ثالثاً: قيس، وعبس، وذبيان، وعبد القيس.
رابعاً: كندة، وحضرموت، وقضاعة، ومهرة.
خامساً: الأزد، وبجيلة، وخثعم، والأنصار.
سادساً: بكر، وتغلب، وبقية ربيعة.
سابعاً: قريش، وكنانة، وأسد، وتميم، وضبّة، ورباب... »[239].
وذُكرَ أنَّ هذا التصنيف تغيّر أيضاً في أيّام معاوية، وعاد رباعياً، فقال الشيخ القرشي عن (تنظيم الجيش): «أُنشئت الكوفة؛ لتكون معسكراً للجيوش الإسلاميّة، وقد نُظّم الجيش فيها على أساس قبلي كما كانوا مُرتّبين وفق قبائلهم، وكانوا يُقسّمون في معسكراتهم باعتبار القبائل والبطون التي ينتمون إليها، وقد رُتبت كما يلي:
نظام الأسباع: ووزع الجيش توزيعاً سُباعياً، يقوم قبل كلّ شيء على أساس قبلي، بالرغم من أنَّهم كانوا يقاتلون في سبيل الله إلّا أنَّ الروح القبلية كانت سائدة ولم تضعف...
وظلّت الكوفة على هذا التقسيم حتى إذا كانت سنة (50ه)، عمد زياد بن أبيه حاكم العراق، فغيّر ذلك المنهج وجعله رباعياً، فكان على النحو الآتي:
1ـ أهل المدينة[240]، وجعل عليهم عمرو بن حريث.
2ـ تميم، وهمدان، وعليهم خالد بن عرفطة.
3ـ ربيعة بكر، وكندة، وعليهم قيس بن الوليد بن عبد شمس.
4ـ مذحج وأسد وعليهم أبو بردة بن أبي موسى.
وإنَّما عمد إلى هذا التغيير لإخضاع الكوفة لنظام حكمه، كما أنَّ الذين انتخبهم لرئاسة الأنظمة قد عُرفوا بالولاء والإخلاص للدولة. وقد استعان بهم ابن زياد لقمع ثورة مسلم. كما تولى بعضهم قيادة الفرق التي زجّها الطاغية لحرب الإمام الحسين، فقد كان عمرو بن حريث وخالد بن عرفطة من قادة ذلك الجيش»[241].
وقد ذكر السيّد البراقي في (تاريخ الكوفة) أسماء جميع بطون هذه القبائل التي نزلت فيها بعد التمصير، وذكر عن لوط بن يحيى الأزدي وغيره: «إنَّه كان بالكوفة ثلاثمائة وستون قبيلة وأربعمائة راية»[242].
وسنذكر ما ورد فيه بـ(تصرّف) لأهميته في معرفة أسماء هذه البطون؛ لأنَّها تُعرف بجميع مَن ذُكر لقبه في واقعة كربلاء:
النزاريون:
1ـ كندة، وهم: معاوية، الأشرس، بنو عمرو، بنو وهب، السكون، السكاسك، تجيب العوادر، الصدف.
2ـ مذحج، وهم: جلد، سعد العشيرة، مراد، عنس، الحارثيون، عبد المدان، بنو الدنان، بنو مسلية... النخع، جنب، مرثد، مازن، أدد، صداء الفلي، هفان، شمران، سيحان، بنو عبيدة، حكم، صعب، جعفر، حرث، غطيف، سلمان، قرن... أنعم، سيف، محادرة، رواق، زهر، حرب، يام، قرية، حكم، قدح، هيس، صدقة، بندقة، عمرو، صومعة، بنو عبد الجد، عبس، الجحافل، بنو نهيك، صعب.
3ـ طيء، وهم جذيلة، الغوث، ثعلبة بن رومان، وثعلبة بن ذهل، وثعلبة بن جدعان بن ذهل بن رومان، بنو تيم... بنو صنبر، بنو طريف، بنو ثمامة، بنو لام، بنو ثعل، بحتر، سنبس، جرم، نبهان، بولان.
4ـ أشعر، وهم: الجماهر، جدة، أنعم، أدعم كاهل، عبد شمس، عبد الثريا، عامر، عارض، ثابت، ناعم، الركب، تاج، شعذف، يقرم، جماد، شهلة، المحتار، حسيب، عيدل، الأفخوذ، الأخلود، الأخبوق، الأخدوع، الأعيوق، ناجية، الحنيك، وائل، غاسل، دحران، صمامة، حسامة، سدوس، سايب، ياسر، مجيد، بجيلة، مريطة، زعيج، بنو أعر، الزجالة، الزمالة، بنو بجير، المساور، بنو حكيم، عبس.
5ـ لخم، وهم: الداريون بنو أراش، بنو جدس، بنو نمارة.
6ـ جذام: أفصى، غطفان، عاملة.
7ـ أزد، وهم: جفنة، غلبة، خزاعة، مازن، بارق، المعي، الحجر، العتيك، راسب، عامل، والبة، ثمالة، لهب، زهران، الحدان، يشكر، عك، دوس، فهم، الجهاضم، الأشاقر، قسامل، الفراديس، سليح، عوف، بنو عدي، بنو فهير، سلول، مصطلق، الحبا.
8 ـ خثعم، وهم: شهران، نهيس، ولود أكلب، قسر... عرينة، أحمس، دهن.
9ـ همدان، وهم: حاشد، بكيل، حجور، قدم، أدران، أهنوم، راهب، شاور، خيوان، غدر، وادعة، يام، شبام، جشم، تغلب، مذكر، هبيرة، العزة، دعام، مرهبة، أرحب، شاكر، سفيان، ذبيان، بنو حريم، بنو صاع، بنو مدلج، بنو حملة، أسلم، الأقروح.
المضريون:
1ـ قيس عيلان وبطونه: هوازن، غطفان، سُلَيم، فهم، عدوان، غني، باهلة.
وأمّا مدركة، فبطونه: قريش، أسد، القارة، هُذيل.
وأمّا طابخة، فبطونه: تميم، الرباب، ضبة، مزينة، حميس، كاهل، فقعس، دودان، عمرو، صعب، والبة، صيدا، ناشب، غاضرة، غنم، ثعلبة، عضل، بنو لحيان، بنو دهمان، بنو غازيه، بنو صاهلة، بنو ضاعنه، بنو فناعة، هذيل، تميم بن مر، دارم، مجاشع، نهشل، سدوس، حنظلة، يربوع، رياح، سليط، البراجم، كليب، الهجيم، مازن، بنو منقرة، عمر، قيس، غالب، طلفة، ظليم، بنو العنبر، بنو عطارد، بنو عدانة، عدي، عوف، ثور، أطحل، أشيب، عكل، عامر، كلاب الضباب، جعدة، الجريش، قُشير، عقيل، خفاجة عجلان، نمير، هلال، سلول، نصـر، غزية، جشم، سعد، ثقيف، عامر، بنو مطرود، بنو الشـريد، بنو ذكوان، بنو أبهر، ذبيان، عبس، بنو أشجع، بنو عبد الله، بنو أعود، بنو مخزوم، بنو رواحة، بنو سهم، بنو فزارة، بنو أنمار.
هؤلاء كلّهم يجمعهم مضر الحمراء.
2ـ ربيعة أخو مضر، وهم: عنزة، عبد القيس، تيم، بنو جشم، بنو حصين، بنو أرقم.
3ـ إياد أخو مضر وربيعة، وهم: بقت، بنو حذافة، بنو دعمي، بنو طماح.
4ـ قضاعة، وهم: بنو الحارث، بنو الحافي، بنو عمران، بنو أسلم، بنو حلوان، نهد، جهينة، عذرة، جرم، البرك، كلب، أسد، حيدان، مهرة، بلي، مجيد، يزيد، بهرا، خولان، حي، رزاح، صحاري، هاني، رسوان، سعد، وداعة، الأقارع، مسبح، الكحل، هزان، الكرب، منبه، بنو جماعة، بنو غالب، بنو حرب، ربيعة، بنو أبحر، العقارب، بنو عوف، بنو مالك، الأنبار، الفاطميون، بنو عبيدة، بنو سليح، بنو تنوخ، القين، الحنش، زبيد غير زبيد مذحج.
5ـ العكوك أولاد عك بن عدنان، أخي معد، وهم: النعمان، والضحاك والشهد، وعبد الله، وتفرّعت منهم: غافق، ساعدة، بنو قين، بنو مقصـر، رهينة، رامي، دب، لعسان، شبام، الركب، لام، صخر، دعج، يعج، رعل، قاصية، علافة، هامل، والبه، قحر، فخر، وابصة، وزن، رقابة، راشد، زهير، مالك، زوال، صريف، زيد، بنو حييس، بنو المحدون، عبيدة، الحجبة، غنم، ناج منك، عمران، بجيلة، الخبا، الهزمة، الحوية، سيعة، المطارفة، الحديون، صهيب، الزيول، الأضم، هليل، الواغط، العبديون، الكعبيون، المياريون، الراسبون، بنو رضوان، بنو حبيش، بنو وهبان، العليون،، الحربيون. فهؤلاء الذين توطنوا الكوفة، وهم زهاء (400) بطن»[243].
وأخيراً نذكر أنَّ ما ذُكر في هذا الفصل هو إشارات عن تلك المواضيع التي طلب المؤلف من السائل أن يبحث ويحقّق فيها، وقد أشرنا أيضاً إلى بعض المسائل المهمّة التي يجب أن تُفرد بتحقيق خاصّ لا يحتمله هذا الكتاب.
رسالة في عدد المُخرَجِين لحربِ الحسين × في الطفّ
وبه ثقتي.
اللهمَّ لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم، وصلّ اللهمَّ عليهم، والعنْ أعداءهم[245].
سألت[246] (أدام الله تعالى تأييدك، وزاد شرفك وعزّك)، عمَّن زاد على أربعة آلاف في عدد المُحاربين في الطفِّ لسيّد الشهداء، من الُمؤرخين، أو المُحدّثين من علماء السنَّة.
وذكرت (زاد الله في فضلك)، أنَّ أبا جعفرٍ الطبري في (تاريخه الكبير)[247] ذكرهم أربعة آلاف[248]، وأنَّك لم تعثرْ على مَن زاد على ذلك منهم إلّا علماء أصحابنا[249]، وأحببت الوقوف على الحقيقة وعلى[250] المُصرِّح بالزيادة من علماء الجمهور؟
فأقول ـ وبالله التوفيق[251]ـ: الذين صرَّحوا بالزيادة، ممّن[252] يحضرني في كتبهم جماعة: منهم: كمال الدين أبو سالم محمد بن طلحة القرشي النصيبي[253] الشافعي في كتاب (مطالب السؤول في مناقب آل الرسول)، المتوفّى سنة (652هـ)، قال ما نصُّه: «فقد صرَّح النقلة في صحائف السِّير بما رواه[254]، وجزموا القول بما نقله المتقدّم إلى المتأخر، فيما رووه: أنَّ الحسين لمّا قصد العراق وشارف الكوفة، سرّب إليه[255] أميرهم يومئذٍ عبيد الله بن زياد الجنود لمقاتلته أحزاباً، وحزّب عليه الجيوش لمقاتلته أسراباً، وجهّز من العساكر (عشـرين ألف) فارسِ وراجلٍ، يتتابعون كتائباً وأطلاباً[256]...»[257]. إلى آخر كلامه.
وقد ترجم ابنَ طلحة، اليافعيُّ في (مرآة الجنان)، في حوادث سنة (652هـ)، قال:
«كان رئيساً مُحتشماً، بارعاً في الفقه والخلاف، وولي الوزارةَ مرّةً، ثُمّ زَهدَ وجمعَ نفسَه، وتوفّي بحلب في شهر رجب، وقد جاوز السبعين»[258].
ثمَّ أطال في الترجمة، حكاها في العبقات[259].
وحكى مدح ابن طلحة عن (طبقات الشافعية) للأسنوي، ونقل عبارته بطولها، وأنَّه: «كان إماماً بارعاً في الفقه والخلاف، عَارفاً بالأُصوليّين، رئيساً كبيراً مُعظّماً»[260].
ثمَّ حكى ترجمته أيضاً عن (طبقات الشافعية) لابن السبكي، وفيها: «تولُّده سنة (582هـ) وسمع الحديث، وحدّث ببلادٍ كثيرةٍ في سنة (648هـ) إلى أنْ قال: كان أحد العلماء المشهورين والرؤساء المذكورين».
وذكر في مصنفاته «العقْد الفريد للملك السعيد»[261].
وفي كشف الظنون: «العقدُ الفريدُ للملك السعيد، لأبي سالم محمد بنٍ طلحة القرشي النصيبي الوزير، المتوفّى سنة (652هـ)»[262]، إلى آخر كلامه.
فالرجل من عظماء علماء السنَّة.
وكتابه (مطالب السؤول) مذكورٌ في (كشف الظنون)، وفي ترجمته في المصنفات[263].
نقل كلام ابن الصباغ أنَّهم كانوا ثلاثين ألفاً.
و(منهم): الشيخ نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي، المتوفّى سنة(855هـ) في كتابِه (الفصول المهمّة):
قال بعد قوله: وجمع ـ يعني ابن زياد[264] ـ الجموع (وحشّد الحشود)[265]، وجهّز إليه العساكر، وجعل مُقدَّمها عمر بن سعد ما لفظه بحروفه: «فخرجَ عمرُ بن سعدٍ إلى الحسين×[266]، وصارَ ابنُ زياد يمدُّه بالجيوش شيئاً فشيئاً[267] إلى أن اجتمع عند عمر بن سعد (ثلاثون ألف)[268] مقاتل ما بين فارسٍ وراجلٍ...»[269]. إلى آخره.
في بيان مدح ابن الصباغ ومَن اعتمد كتابه من العامّة
وقد أخرج في (العبقات) ترجمة ابن الصباغ من عدّة مُصنفات لعلماء السنَّة مثل[270]: (ذخيرة المآل) لأحمد بن عبد القادر العجلي[271]، و(الرياض الزاهرة) للطبري[272]، وأنَّ كتابه (الفصول المهمّة) من الكتبِ التي اعتمد عليها السمهودي في (جواهر العقدين)[273]، والحلبي في (إنسان العيون)[274].
وعدّ آخرين منهم اعتمدوا (فصوله المهمّة)[275] وعدّهم واحداً بعد واحدٍ[276]، فهو من الكتبِ المعتمدة.
و(منهم): السيّد جمال الدين، أحمد بن علي بن الحسين علي بن مهنا بن (عنبة)[277] المتوفّى سنة(826هـ).
في كتابه (عمدة الطالب في أنسابِ آل أبي طالب)، وقد ذكره في (كشف الظنون)[278]، وهو عند الجميعِ من الكتب المعتمدة[279].
قال: «فلمّا صار إلى كربلاء منعوه عن المسير[280]، وأرسلوا (ثلاثين ألفاً)، عليهم عمر بن سعد بنِ أبي وقاص»[281] إلى آخر كلامه.
لم يذكر ابن جرير في (تاريخه) عدد المُخرَجين إلى حرب الحسين×، وإنَّما ذكر ورود عمر بن سعد إلى كربلاء في (أربعة آلاف)، قال ما لفظه: «فلمّا كان من الغد قدِم عليهم عمر بن سعد بنِ أبي وقاصٍ من الكوفة، في (أربعة آلاف)، قال[282]: وكان سبب خروجِ ابنِ سعد إلى الحسين×؛ أنَّ عبيد الله بن زياد بعثه على (أربعة آلاف) من أهلِ الكوفة يسير بهم إلى (دَسْتَبى)[283]، وكانت الديلم قد خرجُوا إليها وغلبوا عليها، فكتب إليه[284] ابن زياد عهده على (الري) وأمره بالخروج، فخرج معسكراً بالناس بـ(حمّام أعين)، فلمّا كان من أمرِ الحسينِ ما كان، وأقبل إلى الكوفة، دعا ابن زياد عمر بن سعد، فقال: سِرْ إلى الحسين»[285] إلى آخر القصة انتهى.
في بيان عدم مُنافاة كلام ابن جرير الطبري لذلك
وهذا لا يدلُّ على الحصرِ، وأنَّه ما خرج قبله أحدٌ ولا خرج بعده أحدٌ، وكيف يدلُّ، وقد ذكر ابن جرير نفسه بعد ذلك ما يدلُّ على خروج كلِّ القبائل! قال ما لفظه: «كان على ربع أهل المدينة يومئذٍ عبد الله بن زهير بن سُليم الأزدي، وعلى ربع مذحج وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الحنفي[286]، وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى ربع تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الرياحي. فشهد هؤلاء كلُّهم مقتل الحسين، إلّا الحرّ بن يزيد: فإنَّه عدل إلى الحسين وقُتلَ معه»[287].
ثمَّ حدّث[288] بإسناده عن الطرمّاح بن عدي أنَّه دنا من الحسين، فقال له: «والله، إنِّي لاُنظر فمَا أرى معك أحداً، ولو لم يقاتلك إلّا هؤلاء الذين أراهم مُلازميك [يعني الحرّ وأصحابه] لكان كفى بهم، وقد رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيومٍ ظهر الكوفة، وفيه من الناس ما لم ترَ عيناي في صعيد واحد جمعاً أكثر منه، فسألت عنهم، فقيل: اجتمعوا ليُعرضوا، ثمَّ يُسرَّحُون إلى الحسين»[289] الحديث.
أترى أنَّ هذه القبائل والناس الذين لم ترَ عينا الطرمّاح جمعاً أكثر منهم، هم (الأربعة آلاف) أصحاب عمر بن سعد؟
وهو ممّن رأى جمع الحاجّ بعرفة، وكانت قد تجمّعت لعمر بن سعد (من قبلُ)[290] على أن يسير بها إلى الري لحرب الديلم، فأمره ابن زياد بالخروج إلى حرب (الحسين×)[291]، وأولئك الذين رآهم الطرمّاح جُمعوا للعرض والتكتّب، وأصحاب عمر بن سعد مُكتتبين من قبلُ كما عرفت بهم[292].
وهم أيضاً غير (ألف) الحرّ الذين ورد الطرمّاح، فوجدهم قد حاصروا الحسين.
وغير (الأربعة آلاف) الذين هم أصحاب الحصين، الذين كان رتّبهم من (القادسية) إلى (خفّان) ومن (خفّان) إلى [العذيب][293]، قبل ورود الحسين× كربلاء، وهؤلاء لم يكن[294] يراهم الطرمّاح.
بل في بعض التواريخ: إنَّ الحصين[295] أرسل الحرّ بـ(ألف) فارسٍ لحبسِ الحسين، وعلى حالهم[296]، غير مَن رآهم الطرمّاح كما هو ظاهرٌ، ثمَّ جاء الحصين بهم كربلاء[297].
فتحصّل ممّا ذكرنا: إنَّ (أربعة آلاف) ابن سعد كانوا مُكتتبين ومُجنّدين من قبلُ لدستبى[298]، والذين رآهم الطرمّاح غير مُكتتبين ولا مُجنّدين، بل جُمعوا للعرض والتجنيد.
منهم: القبائل الذين ذكرهم ابن جرير، وذكر حضورهم حرب الحسين، ولم يستثنِ منهم إلّا الحرّ.
وتحصّل أيضاً أنَّ (أربعة آلاف) ابن سعد غير (ألف) الحرّ، وغير (أربعة آلاف) الحصين[299]، الذي[300] كان خرج بهم قبل ورود الحسين× إلى العراق، ورتّبهم من (القادسية) إلى (خفّان).
فلا يمكن أن ينسب بعد هذا أحدٌ إلى ابن جرير أنَّه لم يذكر إلّا (الأربعة[301] آلاف)[302].
وقد صرّح محمد بن أبي طالب على ما حكاه في (البحار): إنَّ الجمع والتحشيد كان بعد خروج عمر بن سعد[303]، وقد قال: «ثمَّ جمع ابن زياد الناس في جامع الكوفة، ثمَّ خرج، فصعد المنبر، ثمَّ قال: أيُّها الناس، إنَّكم بلوتُم آل أبي سفيان، فوجدتموهم كما تُحبّون، وهذا أمير المؤمنين يزيد قد عرفتمُوه حسن السيرة، محمود الطريقة، مُحسناً إلى الرعيّة[304]، يُعطي العطاء في حقّه، قد أمنت السبل على عهده، وكذلك كان أبوه معاوية في عصره، وهذا ابنه يزيد من بعده، يُكرم العباد، ويُعينهم بالأموال[305]، ويُكرمهم، وقد زادكم في أرزاقكم مائةً مائةً، وأمرني أن أُوفرها عليكم، وأُخرجكم إلى حرب عدوّه الحسين، فاسمعوا له وأطيعوا.
ثمَّ نزل عنِ المنبر، ووفر الناس العطاء، وأمرهم أن يخرجوا إلى حرب الحسين×، ويكونوا عوناً لابنِ سعد على حربه.
فأوّل مَن خرج شمر بن ذي الجوشن في (أربعة آلاف)، فصار ابن سعد في (تسعة آلاف).
ثمَّ اتبعه بيزيد بن ركاب الكلبي في (ألفين)، والحصين بن نمير السكوني في (أربعة آلاف)، وفلانا المازني في (ثلاثة آلاف)، ونصر بن فلان في (ألفين)[306]، فذلك (عشرون ألفاً).
ثُمَّ أرسل إلى شبث بن ربعي... إلى أن قال: فما زال يُرسل إليه العساكر حتّى تكامل عنده (ثلاثون ألفاً)، ما بين فارسٍ وراجلٍ»[307]، إلى آخر كلامه.
وهو صريحٌ، فإنَّ هذه البعوث كانت بعد خروجِ ابن سعد، فهُم الناس[308] الذين رآهم الطرمّاح في ظهر الكوفة، ولم يرَ قطٌّ جمعاً أكثرَ منهم[309]، وصريحٌ أيضاً أنَّ ابن سعد كان في (خمسة آلاف)، الأربعةُ التي خرج بها و(ألف) الحرّ.
ويشهد لهذا الكلام عبارات (ابن طلحة)، و(ابن الصباغ) المتقدّمة المُصـرِّحة بأنَّه خرج ابن سعد، وصار ابن زياد يمدّه بالجيوش شيئاً فشيئاً[310] إلى أن اجتمع عند عمر بنِ سعد (ثلاثون ألف) مقاتل.
نقل كلام المسعودي في كتاب إثبات الوصية
وما ذكره المُسعودي[311] في كتابهِ(إثبات الوصية)، الذي نُصَّ[312] على أنَّه له، في: (فوات الوفيات)[313]، وفي (فهرست النجاشي)[314]، و(الخلاصة في الرجال)[315].
قال ما نصُّه: «وتوجّه عبيد الله بن زياد بالجيوشِ[316] مِن قِبل يزيد في ثمانية وعشـرين ألف»[317]، إلى آخر كلامه.
لا يقالُ إنَّ المسعودي ذَكَرَ في (مروج الذهب) غير ذلك.
لأنَّا نقولُ: إنَّه صنّفه بمصر لبعضِ مَن لا يسعه ذكر كلّ شيء، كما يعرفه الخبير بترجمة المسعودي[318].
كلام سبط ابن الجوزي في (تذكرة الأئمّة)
وكذلك كلام سبط ابن الجوزي في التذكرة لا يدلُّ على غيرِ ما ذكره ابن جرير من إرسال عمر بنِ سعد في (أربعة آلاف)، قال: «كان ابن زياد قد جهّز عمر بن سعد بن أبي وقاص لقتال الحسين في (أربعة آلاف)، وجهّز (خمسمائة فارس)، فنزلوا على الشرائع.
وقال ابن زياد لعمر بن سعد: اكفني هذا الرجل.
وكان عمر يكره قتاله، فقال: اعفني. فقال: لا أُعفيك.
وكان ابن زياد قد ولّى عمر بن سعد الري وخُراسان[319]، فقال: قاتله وإلّا عزلتك. فقال: أمهلني الليلة أُفكّر»[320]. إلى آخر القصة المعروفة.
فيدلُّ كلامه على أنَّه لا يريد بيان الحصـرِ، ولا بيان عدد المُخرَجين من الأوّل إلى الآخر، وإنَّما أراد بيان ما كان استعدّه ابن زياد في أوّل الأمرِ.
فلا معارضة في كلامه لمَن ذكر أنَّه بعث بعد عمر بن سعد فلاناً وفلاناً أصلاً.
في نقل كلام ابن الأثير في (الكامل) وأنَّه نحو كلام ابن جرير
وأمّا ابن الأثير فلم يذكر إلّا ما ذكره ابن جرير الطبري، فقال: «ثمَّ نزل [يعني الحسين×] كربلاء، وذلك يوم الخميس الثاني من مُحرّم إحدى وستين، فلمّا كان الغد قدِم عليهم عمر بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة في (أربعة آلاف).
وكان سبب مسيره إليه؛ أنَّ عبيد الله بن زياد كان قد بعثه على (أربعة آلاف) إلى دستبى، وكانت الديلم قد خرجُوا إليها وغَلبوا عليها، وكتب له عهده على الري، فعسكر بالناسِ في (حمّام أعين)، فلمّا كان من أمرِ الحسين ما كان دعا ابن زياد عمر بن سعد، وقال له: سرْ إلى الحسين، فإذا فرغنا ممّا بيننا وبينه سرت إلى عملك».
إلى أن قال: «[ثمَّ أتى ابن زياد، فقال له: إنَّك ولّيتَني هذا العمل وسمع الناس به][321] فإنْ رأيت أنْ تنفذَ لي عملك[322] فافعلْ، وابعث إلى الحسين من أشراف الكوفة مَن لست أُغني في الحرب منه، وسمّي أُناساً. فقال له ابن زياد: لست أسْتأمُرك فيمَن أُريد أنْ أبعث، فإنْ سرت بجندنا وإلّا فابعث إلينا بعهدنا. قال: فإنِّي سائرٌ، فأقبلَ في ذلك الجيش حتّى نزل بالحسين»[323].
التحقيق في توهّم عدد المُحاربين
فعُلم من هنا أنَّ الذي جاء به ابن سعد هو جيش (دستبى)، الذي كان مُعدّاً لحربِ (الديلم)، فهم غير مَن رآهم الطرمّاح في صعيد واحد قد جُمعوا ليُعرضوا، ثمَّ يُسرّحوا إلى الحسين.
ضرورة أنَّ (الأربعة آلاف) الذين كانوا قد بُعثوا إلى (دستبى) لا يحتاجون إلى العرضِ كما هو ظاهرٌ، والذين رآهم الطرمّاح لا يمكن أن يكونوا (أربعة آلاف)؛ لأنَّ لفظ ما رواه ابن جرير وابن الأثير في ذلك: إنَّ الطرمّاح قال: «وفيه [يعني ظهر الكوفة] من الناس ما لم ترَ عيناي في صعيد واحد جمعاً أكثر منه».
استفادة من كلام ابن زياد في الزيادة
ثمَّ في قول ابنِ زياد لابن سعد: «لست أَسْتأمُرك فيمَن أُريد أن أبعث» دلالة واضحة على أنَّه كان يريد أيضاً أن يبعث بُعوثاً غير عمرِ بن سعد إلى حربِ الحسين×.
ويُؤيده ما ذكره ابن جرير وابن الأثير من أنَّ عمر بن سعد: «جعلَ على ربعِ أهلِ المدينة عبد الله بن زهير الأزدي، وعلى ربعِ ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس، وعلى ربعِ مذحج وأسد عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، وعلى ربعِ تميم وهمدان الحرّ بن يزيد الرياحي».
ثمَّ قالا: «وجعلَ على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدي، وعلى ميسـرته شمر بن ذي الجوشن، وعلى الخيل عروة بن قيس الأحمسي، وعلى الرجّالة شبث بن ربعي التميمي».
وظاهرٌ أنَّه لم
يكونوا هؤلاء الربوع والقبائل، وهؤلاء الرؤساء، في (الأربعة آلاف) الذين كانوا تحت
رايته في بعث (دستبى) بالضـرورة، وكيف يكونون (أربعة آلاف) وقد اجتمعت عشائر
الكوفة جميعاً، وكلُّ واحد من العشائر تزيد على(أربعة آلاف)،
كما لا يخفى على أهلِ العلم بالتواريخ.
عشائر أهل الكوفة الذين تقاسموا الرؤوس يوم الطفّ
قال ابن الأثير: «قال سليمان: لمّا قُتلَ الحسين ومَن معه حُملت رؤوسهم إلى ابنِ زيادٍ، فجاءت كندة بثلاث عشـر[324] رأساً، وصاحبُهم قيس بن الأشعث، وجاءت هوازن بعشـرين رأساً، وصاحبُهم شمر بن ذي الجوشن الضبابي، وجاءت بنو تميم بسبعة عشر رأساً، وجاءت بنو أسد بستة رؤوس، وجاءت مذحج بسبعة أرؤسٍ، وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤس، فذلك سبعون رأساً»[325].انتهى موضع الحاجة.
فلينظرِ العاقل كم عدد كندة؟ وكم عدد هوازن؟ وكم بنو تميم؟ وكم بنو أسد؟ وكم مذحجُ؟[326]، ودعْ عنك سائر الجيوش.
فمَن أراد الوقوف على الحقائق أخذ بما جُمع مما جاء في هذا البابِ، وأمعن النظر فيه، وأعطى كلَّ كلامٍ حقَّه.
فإنِّي لا أنسى أنَّ كندة اثنا عشـر ألفاً يوم صفّين[327]، ولا يحضـرُ ببالي عدد باقي العشائر.
ومَن أراد الوقوف على عددهم بالتقريبِ يراجع كتاب ابن سعد[328]، ونصـر بن مُزاحم في (صفّين)[329]، وأمثالهما يعرف الحال.
وله أبوابٌ أُخر وطرقٌ كثيرةٌ في معرفة عدد الطوائف بالكوفة، والذين كانوا من هذه الطوائف بـ(صفّين)، وقبلها مع سعد بن أبي وقاص.
وبالجملة الاعتبار يساعده على ما ذكره ابن طلحة، وابن الصباغ، والمسعودي وابن عنبة النسابة.
أدلّة أُخرى في تعداد المُحاربين
بيان أنَّ الحسين قتل (1950)، وأنَّهم كانوا ثلاثين ألفاً، والرماة أربعة آلاف.
وقال محمد بن أبي طالب، وابن شهر آشوب في المناقب: «ولم يزل يُقاتل حتّى قتل ألف وتسعمائة وخمسين سوى المجروحين، فقال عمر بن سعد لقومه: الويل لكم أتدرُون لمَن تقاتلون! هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتّال العرب، فاحملُوا عليه من كلِّ جانبٍ. فحملوا بالطعن مائة وثمانين، وأربعة آلاف بالسهام»[330].
قلت: والشاهد من هذا الكلامِ في موضعين:
الأوّل: إنَّه قتل ألف وتسعمائة وخمسين رجلاً، وهذا يدُّل على أنَّهم كانوا أُلوفاً لا أربعة آلاف.
والموضع الثاني: قوله: وكانت الرماة أربعة آلاف[331]، والظاهر أنَّ الجيش الذي يكون الرماة فيه أربعة آلاف لا بدّ أن يكون ثلاثين ألفاً أو يزيدون.
وقد رأيت في تاريخ ابنِ جريرِ يروي أنَّه×: «قتل ألفاً وثمانمائة رجلاً»[332].
فيصحُّ قول بعضِ مَن حضر المعركة: واللهِ، ما رأيت مكثُوراً قطُّ، قد قُتل ولدُه وأهلُ بيته وأصحابُه أرْبطَ جأشاً منه، وإنْ كانت الرجّالة لتشدَّ عليه فيشدُّ عليهم بسيفه، فينكشفون عنه انكشاف المعزى إذا شدَّ فيها الذئبُ. ولقدْ كان يحمل فيهم وقد تكمّلوا (ثلاثين ألفاً)، فينهزمون من بين يديه كأنَّهم الجراد المنتشـر. ثمَّ يرجع إلى مركزِه، وهو يقول: لا حولَ ولا قوةَ إلّا باللهِ العلي العظيم. رواه السيّد بن طاووس وغيره[333].
هذا ما يحضرني من التواريخ وكتبِ الآثارِ والاستنباطات والاعتبارِ.
وإلّا فقد استفاض النقل بالطرق الصحيحة عن أميرِ المؤمنين، وعن علي بنِ الحسين السجاد، والحسنِ المجتبى، وعن أبي عبد الله الصادق^ أنَّهم (ثلاثون ألفاً)[334].
وهو الذي يساعد عليه الاعتبار، وتصدّقه الآثار، وتعتقده أهل العلمِ بالأخبار.
وليكن بهذا كفاية لسيّدنا الأجلُّ (أدام الله سُبحانه تأييده)، فقد فُتح له باب تحقيق الحقِّ في هذا الباب، فعليه (أدام الله توفيقه) أن يبحث عن عدد العشائر والطوائف المذكورة، وسائر الدلائل والإشارات التي جمعتها له، فإنِّي لا يسعني الوقت لبذل الجهُد في الأخذ بمجامع هذه الأشياء على التفصيل، وأعتذر إليه من التقصير، فإنِّي كما لا يخفى عليه، في شُغلٍ شاغلٍ عن ذلك، والسلام.
حرره الأحقر حسن صدر الدين الموسوي الكاظمي في (ساعتين) من نهارِ الجمعة، حادي عشر محرّم الحرام، سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف (1334هـ).
لقد تقدّم تعريف هذا الفصل وموضوعه، وهو الذي خُصّص للغريب في هذه الرسالة، وكما ذكرت أنِّي نهجت فيه على منوال الشيخ السماوي في (إبصار العين)، واقتبست منه أكثر التراجم، وهي التي لم يذكر لها هامش؛ لأنَّ الكثير مما ورد في هذه الرسالة لم يرد في إبصار العين لاختلاف موضوعها، فتطلّب استخراجه من مصادره، وذكرتها في الهامش، وقد صنفته على ثلاثة أقسام:
الأوّل: في ذكر ترجمة مختصـرة للأعلام.
الثاني: في تعريف المصطلحات وغريب المفردات.
الثالث: في الأمكنة والبلدان والبقاع.
الأوّل: في ذكر ترجمة مختصرة للأعلام
ـ عمر بن سعد بن أبي وقاص: وهو عمر بن سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة، يُكنى بأبي حفص. وأُمّه أَمة، وأُمّ أبيه حمنة بنت سفيان بن أُميّة، وهو ابن عمّ هاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص صاحب علي×.
ـ عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي: كان من أصحاب أمير المؤمنين×، وله ذكر في الحروب والمغازي، وولي الأعمال لآل أُميّة[335].
ـ عبد الرحمن بن أبي سبرة: عبد الرحمان بن يزيد بن مالك بن عبد الله بن ذويب بن سلمة بن عمرو بن ذهل بن مران بن جعفي، وَفَدَ هو وأخوه سبرة مع أبيه على رسول الله’، وكان اسمه عزيزاً، فسمّاه رسول الله| عبد الرحمن، وله مع صحبته أفعال ذميمة.
ـ الحرّ بن يزيد الرياحي: الحرّ بن يزيد التميمي اليربوعي الرياحي، كان شريفاً في قومه جاهليةً وإسلاماً، فإنَّ جدّه عتاباً كان رديف النعمان، والحرّ هو ابن عمّ الأخوص الصحابي الشاعر، وكان الحرّ في الكوفة رئيساً ندبه ابن زياد لمعارضة الحسين×، فخرج في ألف فارس.
روى الشيخ ابن نما: أنَّ الحرّ لمّا أخرجه ابن زياد إلى الحسين، وخرج من القصـر نُوديَ من خلفه: أبشر يا حرّ بالجنّة. قال: فالتفت فلم يرَ أحداً. فقال في نفسه: والله ما هذه بشارة، وأنا أسير إلى حرب الحسين، وما كان يُحدّث نفسه في الجنّة، فلمّا صار مع الحسين قصّ عليه الخبر، فقال له الحسين: «لقد أصبت أجراً وخيراً»[336].
ـ عزرة بن قيس الأحمسي: (بفتح العين المهملة، وسكون الزاء المعجمة، وبعدها الراء المهملة) وصحّفه مَن لم يضبطه بعروة[337].
ـ عمرو بن الحجاج بن سلمة الزبيدي: سيّد زبيد، وله شرف فيهم، وذُكر في المغازي.
ـ شمر بن ذي الجوشن: (بفتح الشين، وكسـر الميم)، ويجري على الألسن ويمضـى في الشعر الحديث كسر الشين وسكون الميم، وهو خلاف المضبوط، وذو الجوشن أبوه، واسمه شراحيل بن الأعور قرط بن عمرو بن معاوية بن كلاب الكلابي الضبابي، وهو قاتل الحسين×، وكان أبرص خارجياً.
ـ شبث بن ربعي: (بفتح الشين المعجمة، والباء المفردة، ثمَّ ثاء مثلثة)، (وكسـر راء ربعي، وسكون بائه المفردة)، ابن حصن التميمي الرياحي، كان مُؤذّن سجاح المتنبئة فيما ذكره الدار قطني. ثمَّ أسلم وصار من أصحاب أمير المؤمنين×، ثمَّ تحوّل بعد صفّين خارجياً، وولده عبد القدوس المعروف بأبي الهندي الشاعر الزنديق السكير، وسبطه صالح بن عبد القدوس الزنديق الذي قتله المهدي على الزندقة، وصلبه على جسـر بغداد.
ـ حجار بن أبجر: (بالحاء المهملة، والجيم المشدّدة، والراء المهملة في حجار)، (والباء والجيم المعجمتين، والراء المهملة في أبجر) بن جابر العجلي[338]، ولحجار سمعة، وأبوه أبجر نصراني مات على النصـرانيّة بالكوفة، فشيّعه بالكوفة النصارى؛ لأجله، والمسلمون؛ لأجل ولده إلى الجبانة.
ـ يزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم: (بضم الراء المهملة وفتح الواو من رويم) الشيباني والأكثر (الحارث)، وكان أبوه من أصحاب أمير المؤمنين×، كان يقال له: ابن لطيفة ـ وكان عثمانياً رأيه، أُمويّا ودّه ـ قتله الخوارج بالري أيّام مصعب بن الزبير[339].
ـ الطرمّاح بن عدي: نُسب إلى طيء ثلاثة من الشعراء باسم الطرمّاح، فالأوّل: وهو أشهرهم في الشعر الطرمّاح بن حكيم الطائي، وهذا ولد في الشام ونشأ في الكوفة، ويرى مذهب (الشـراة) من الأزارقة الخوارج، واتصل بخالد بن عبد الله القسـري، فكان يُكرمه ويستجيد شعره، وكان هجّاءً، معاصراً للكميت صديقاً له.
توفي نحو سنة (125ه)، وقيل عنه: روى عن الإمام الحسن× كما في ترجمته من تاريخ دمشق، وجدّه قيس بن جحدر وَفَدَ على النبي|، وهو ابن ثعلبة بن عبد رضا ابن مالك بن أبان بن عمرو بن ربيعة، بن جرول بن ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيء الطائي، ثمَّ الثعلبي[340].
وأمّا الثاني: فهو الطرمّاح بن الجهم الطائي، ثمَّ العقدي، شاعر راجز، والعقدي نسبة إلى أُمّهم عقدة بنت معتر بن بولان، وإليها يُنسبون[341].
وأمّا الثالث: فهو الطرمّاح بن عدي بن عبد الله بن خيبري الطائي، وعمُّه وَفَدَ على النبي|، وهو «مالك بن عبد الله بن خيبري بن أفلت، بن سلسلة بن عمرو بن سلسلة بن غنم، بن ثوب بن معن بن عتود الطائي، ولمالك ولدان شاعران، وهما: مروان، وإياس»[342]. «الطرمّاح بن عدي: عدّه الشيخ (تارةً) من أصحاب أمير المؤمنين×، قائلاً: رسوله× إلى معاوية، و أُخرى من أصحاب الحسين×»[343].
وله مكالمة مشهورة حينما أرسله الإمام علي× لمعاوية، دلّت على بلاغته وفصاحته وحكمته.
وله أبيات الرجز المشهورة، ومطلعها:
|
يا ناقتي لا
تذعري من زجري |
|
وشمّرى قبل طلوع الفجر[344] |
واختلف المؤرخون في إنشاده هذه الأبيات، فبعضهم ذكر: إنَّه كان يرتجز بها حين كان دليلاً لمَن كان معه، ثمَّ إنَّه ارتجزها أمام الحسين×.
وبعضهم ذكر: إنَّ الإمام الحسين سأله عن الطريق، وأخذ يدلّه ويرتجز أمامه[345]. وفي رواية الطبري أنَّه اعتذر أن يسير معه؛ لأنَّه يحمل ميرة لأهله أخذها لهم من الكوفة، وفيها قال له: «فأنشدك الله، إن قدرت أن لا تقدِم إليهم شبراً فافعل»، وطلب منه أن يذهب معه إلى بلاد قومه؛ حتى يرى رأيه، وأن ينزل جبلهم (أجاء)، وتكفّل له بعشـرين ألف طائي يضربون بين يديه بأسيافهم[346].
ـ الحصين بن نمير التميمي: حصين (بضم الحاء المهملة، وفتح الصاد) بن تميم بن أُسامة بن زهير بن دريد التميمي، صاحب شرطة عبيد الله. ويُذكر أيضاً في الروايات باسم (الحصين بن نمير) كما عند الطبري، ويمضـى في الكتب (حصين بن نمير السكوني)، وهو غلط فاحش، فإنَّ ذلك عند يزيد حارب به أهل المدينة ومكة، وله في محاربة عين الوردة رئاسة في أهل الشام وسمعة.
في شرح النهج لابن أبي الحديد: «أنَّ تميم بن أُسامة بن زهير بن دريد التميمي اعترض الإمامَ علياً×، وهو يخطب على المنبر ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله، لا تسألوني عن فئة تضلّ مائة، أو تهدى مائة إلّا نبأتكم بناعقها وسائقها، ولو شئت لأخبرت كلّ واحدٍ منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه. فقال: فكم في رأسي طاقة شعر؟ فقال له: أَمَا والله، إنِّي لأعلم ذلك، ولكن أين برهانه لو أخبرتك به، ولقد أخبرتك بقيامك ومقالك. وقيل لي إنَّ على كلّ شعرةٍ من شعر رأسك ملكاً يلعنك وشيطاناً يستفزك، وآية ذلك أنَّ في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، ويحضّ على قتله. فكان الأمر بموجب ما أخبر به×، كان ابنه حصين (بالصاد المهملة) يومئذٍ طفلاً صغيراً يرضع اللبن، ثمَّ عاش إلى أن صار على شرطة عبيد الله بن زياد، وأخرجه عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين×، ويتوعّده على لسانه إن أرجأ ذلك، فقُتل× صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته»[347].
وفي تاريخ دمشق: «بعث المختار برأس ابن زياد، ورؤوس الناس من أشراف أهل الشام، فيهم حصين بن نمير الكندي، وكان فيمَن قاتل ابن الزبير...»[348]. فالرجل من أهل الشام من مدينة حمص، ولم يأتِ إلى الكوفة، ولم يشترك في معركة كربلاء، وإذا قلنا بحضوره لكان له شأن كبير وذكر واضح في قيادة الجيش. وفي الصحيح من مقتل سيّد الشهداء وأصحابه، قال: «جدير بالذكر أنَّ بعض الجرائم المذكورة في عدد من المصادر نُسبت إلى (حصين بن تميم بن أُسامة بن زهير بن دريد التميمي)، والذي لا يمكن اتحاده مع الشخص المعنيّ في ترجمتنا (حصين بن نمير السكوني)، ويُحتمل أن يكون قد حصل تصحيف، أو خلط في نسبة الجرائم، إلّا أنَّ من المُسلّم به هو أنَّ حصين بن نمير كان أحد القواد الأصليين والرئيسين للجيش الأُموي في صفّين، وواقعة عاشوراء وواقعة الحرّة ومكة، وكذلك الحرب مع التوابين والمختار الثقفي»[349].
ـ الوليد بن عمرو: وهو رئيس ثقيف بعد رجوعها من الطفّ، وجاء باثني عشـر رأساً.
ـ هلال الأعور: وهو رئيس بني أسد في رجوعهم بعد الطفّ، وجاء بستة رؤوس.
ـ عيهمة بن زهير: وهو رئيس الأزد في رجوعهم، وجاء بخمسة رؤوس بعد واقعة الطفّ[350].
ـ كعب بن طلحة: ذُكر أنَّ عبيد الله بن زياد بعثه في ثلاثة آلاف لحرب الإمام الحسين×.
ـ مضاير بن رهينة المازني: وذُكر أنَّه بُعث في ثلاثة آلاف لحرب الإمام الحسين×.
ـ نصـر بن حرشة: وذُكر عنه أيضاً أنَّه بُعث في ألفين لحرب الإمام الحسين×[351].
الثاني: في تعريف المصطلحات وغريب المفردات
أرباع الكوفة: وهي المدينة، وكندة، ومذحج، وتميم، وتدخل ربيعة مع كندة، وأسد مع مذحج، وهمدان مع تيمم، وتنضم غيرهم إليهم في الجميع، يقال: أرباع الكوفة وأخماس البصرة.
عرض الجند على القائد، أي: إمرارهم أمامه؛ ليُعلم حالهم، قال الخليل: «وعرضت الجند عرض العين، أي: أمررتهم عليّ؛ لاُنظر ما حالهم، ومَن غاب منهم»[352].
وأمّا التكتّب فله معانٍ، منها: (التكتّب) بمعنى التهيّؤ والتجمع، قال الفيروزآبادي: «وكتّبها تكتيباً: هيأها. وتكتّبوا: تجمعوا»[353].
وله معنى آخر: وهو العقد والاتفاق، وفي القاموس المحيط: «التكاتب، أن يُكاتبك عبدك على نفسه بثمنه، فإذا أداه عُتق»[354].
قال ابن الأثير: «المكثور المغلوب، وهو الذي تتكاثر عليه الناس»[355]، وفي لفظ الطبري: «فوالله ما رأيت مكسوراً قطُّ... »[356]، والصحيح مكثور (بالثاء المثلثة) بقرينة سائر الكتب الواردة فيها هذه الرواية. وفي البداية والنهاية عن عبد الله بن عمار، قال: «رأيت الحسين حين اجتمعوا عليه يحمل على مَن على يمينه حتى انذغروا عنه، فوالله ما رأيت مكثوراً قطُّ قد قُتل أولاده وأصحابه أربط جأشاً منه، ولا أمضـى جناناً منه، والله ما رأيت قبله ولا بعده مثله»[357].
الثالث: في الأمكنة والبلدان والبقاع
ـ دَسْتَبى: «(بفتح أوّله وسكون ثانيه، وفتح التاء المثناة من فوق، والباء الموحدة المقصورة)، كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهمذان، فقسم منها: يُسمّى دستبى الرازي، وهو يقارب التسعين قرية، وقسم منها: يُسمّى دستبى همذان، وهو عدّة قرى، وربما أُضيف إلى قزوين في بعض الأوقات لاتصاله بعملها»[358].
ـ حمّام أعين: من نواحي الكوفة، ونُسب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص[359].
ـ خفّان: (بالخاء المعجمة، والفاء المشدّدة، والألف والنون)، موضع فوق الكوفة قرب القادسية[360].
ـ الثعلبية: (بالثاء المثلثة والعين المهملة، والباء المفردة، والياء المثناة من تحت)، موضع في طريق مكة، يقال: هو ثلثا الطريق من الكوفة[361].
ـ القادسية: موضع معروف من منازل الحاجّ عند الكوفة، بينه وبينها خمسة عشـر فرسخاً.
ـ العذيب (عذيب الهجانات): موضع فوق الكوفة عن القادسية أربعة أميال، وهو حدّ السواد، وأُضيف إلى الهجانات؛ لأنَّ النعمان بن المنذر ملك الحيرة كان يجعل فيه إبله، ولهم عذيب القوادس وهو غربي عذيب الهجانات.
ـ القُطْقطانة: (بضم القاف وسكون الطاء)، موضع فوق القادسية في طريق مَن يُريد الشام من الكوفة، ثمَّ يرتحل منها إلى عين التمر[362].
ـ لَعلع: (بفتح اللام وسكون العين)، جبل فوق الكوفة، بينه وبين السلمان عشـرون ميلاً[363].
ـ نَصِيبِين: «فِي أَقْصَى شمالِ الجزِيرة الفُراتيَّة... تُجاوِر مدينة القامشلي السورِيَّة، ليس بينهما غير الحدِّ، نَصِيبِين شماله والقامشلي جنوبه، ويمرُّ فيهِما أحد فروعِ نهرِ الخابورِ. وكانت من المدن العامرة ذات البساتينِ الغنَّاء، حتَّى قيل: إنَّه كان يتبعها أربعون ألف بُستان. وهي على الجادَّة بين الموصلِ وحلبٍ، وما زالت تلك الجادَّة عامرةً»[364].
القرآن الكريم.
إبصار العين في أنصار الحسين×، الشيخ محمد السماوي(ت1370ق)، تحقيق الشيخ محمد جعفر الطبسـي، ط1، 1419هـ، مركز الدراسات الإسلاميّة لممثلية الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلاميّة.
إثبات الوصية، علي بن الحسين بن علي المسعودي(ت 346 ق)، مطبوعات دار الأندلس، 1430هـ/2009م، بيروت.
إحقاق الحق وإزهاق الباطل، القاضي نور الله التستري(ت 1019ق)، وفي هامشه تعليقات السيّد شهاب الدين المرعشي، 1401ق، و1411ق، قم المقدّسة.
اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي)، محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة، وبيروت، 1409ق.
أدب الكاتب، أبو بكر الصولي(335 ق).
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي(ت413ق)، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، ودار إحياء التراث العربي، 1415ق، بيروت.
أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة، أسعد وحيد القاسم، 1997م، الغدير، بيروت.
أُسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المعروف بـ(ابن الأثير الجزري) (ت 630ق)، تحقيق محمد إبراهيم، القاهرة، 1390ق، وطبع بالأُفسيت في المكتبة الإسلاميّة للحاج رياض، والمطبعة الوهبية، مصر.
أسرار الشهادة، الفاضل الدربندي(ت 1286ق)، منشورات الأعلمي، طهران.
الإصابة في معرفة تمييز الصحابة، أحمد شهاب الدين بن علي الشافعي(ابن حجر العسقلاني) (ت852ق)، تحقيق ولي عارف، مطبعة السعادة، 1323ق، مصر، ودار الفكر، 1403ق، بيروت، ومصر(أُفسيت على كلكتا)، وإحياء التراث العربي 1408ق.
أُصول الكافي، محمد بن يعقوب الكليني الرازي(ت329ق)، المكتبة الإسلاميّة، 1388ق، و 1389ق، مؤسسة الوفاء، 1406ق، دار الكتب الإسلاميّة، 1389ق، طهران.
إعلام الورى بأعلام الهدى، الفضل بن الحسن الطبرسي(ت 548 ق)، تحقيق علي أكبر الغفاري، ط1، 1399ق، دار المعرفة، بيروت، وطبعة الحيدريّة، 1365ق، النجف الأشرف.
الأعلام، خير الدين الزركلي(ت 1396ق)، ط4، 1399ق، وط5، 1400ق، دار الملايين، بيروت.
أعيان الشيعة، محسن بن عبد الكريم الأمين الحسيني العاملي الشقرائي (ت1371ق)، إعداد حسن الأمين، ط5، 1403ق، مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة.
أمالي الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق) (ت381ق)، ط5، 1400ق، مؤسسة الأعلمي، ودار الفكر العربي، 1254ق، بيروت.
الإمامة والسياسة، عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة الدينوري) (ت 276ق)، مكتبة ومطبعة مصطفى بابي الحلبي، 1388ق، مصر.
أمل الآمل، محمد بن الحسن الحر العاملي، 1350ق، النجف الأشرف.
الانتخاب القريب من التقريب، السيّد حسن الصدر+، تحقيق الدكتور ثامر كاظم الخفاجي، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.
أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري(ت 279ق)، تحقيق كمال الحارثي، مكتبة الخانجي، 1125ق، مصـر، ومكتبة المثنى، 1396ق بغداد، وتحقيق المحمودي، مؤسسة الأعلمي، بيروت.
الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني التميمي، طبع المستشرق(مرجليوت ليدن)، 1912م، وطبع قاسم محمد رجب، 1970م، ودار الجنان، 1408ق، بيروت.
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي(ت1110ق)، تحقيق ونشـر دار إحياء التراث، ط1، 1412ق، بيروت، ومؤسسة الوفاء، 1400ق، وط4، 1405ق.
البداية والنهاية، إسماعيل بن كثير الدمشقي، تحقيق علي شيري، ط5، 1409ق، دار الكتب العلميّة، مصر، مطبعة السعادة، 1351ق.
تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي(ت1205ق)، دار الهداية، 1306ق، بيروت.
تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي(ت1205ق)، تحقيق علي شيري، 1994م، دار الفكر، بيروت.
تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي(ت1205ق)، دار إحياء التراث العربي، 1405ق، بيروت.
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، محمد بن أحمد الذهبي(ت 748 ق)، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الرائد العربي، 1405ق، القاهرة، ودار الكتاب العربي، 1411ق، بيروت، وحيدرآباد ـ الدكن، 1354ق.
تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري، دار المعارف، بيروت.
التاريخ الكبير، إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري(ت 256ق)، حيدرآباد ـ الدكن، 1361ق، ودار الكتب العلميّة، بيروت.
تاريخ الكوفة، السيّد حسون البراقـي(ت1332ق)، تحقيق ماجد أحمد العطية، استدراكات السيّد محمد صادق آل بحر العلوم (ت 1399ق)، ط1، 1424ه /1382ش، شريعت، انتشارات المكتبة الحيدريّة.
تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي، دار صادر، 1405ق، بيروت.
تاريخ بغداد (مدينة السلام)، أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي(ت463 ق)، حيدرآباد ـ الدكن، 1378ق، والمكتبة السلفيّة، المدينة المنورة، ودار السعادة، مصر.
تاريخ كربلاء المعلى، عبد الحسين الكليدار، طبع 1349هـ، النجف الأشرف.
تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر الدمشقي) (ت571ق)، تحقيق سكينة الشهابي، 1402ق، دمشق، ط1، دار الفكر، 1415ق، بيروت.
تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، حسن الصدر، دار التراث العربي.
تذكرة الحفاظ، شمس الدين الذهبي(ت 748 ق)، تحقيق أحمد السقا، القاهرة، 1400ق، وحيدرآباد ـ الدكن، 1387ق، ودار إحياء التراث العربي مكتبة الحرم المكي، مكة المكرّمة.
تذكرة الخواص(تذكرة خواص الأُمّة)، يوسف بن فرغلي بن عبد الله (سبط ابن الجوزي الحنبلي الحنفي) (ت654ق)، ط2، 1401ق، بيروت، والنجف الأشرف، ومصر.
تراث كربلاء، سلمان آل طعمة، مؤسسة الأعلمي، 1403ه، بيروت.
ترجمة الإمام الحسين بن علي× من تاريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر الدمشقي) (ت571ق)، مؤسسة المحمودي، بيروت.
ترجمة الإمام علي بن أبي طالب× من تاريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر الدمشقي) (ت571ق)، دمشق.
تسلية المُجالس وزينة المجَالس، محمد بن أبي طالب.
التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي.
التعجب من أغلاط العامّة في مسألة الإمامة، أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان الكراجكي(449هـ)، تحقيق فارس حسون كريم.
تعليقات على إحقاق الحق، شهاب الدين المرعشي(ت1411ق)، تصحيح السيّد إبراهيم الميانجي، مكتبة المرعشي، قم المقدّسة.
تكملة أمل الآمل، السيّد حسن الصدر(ت 1354ق)، تحقيق السيّد أحمد الحسيني، 1406هـ، الخيام، مكتبة آية الله المرعشي، قم المقدّسة.
تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت852 ق)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط1، 1415ق، دار الكتب العلميّة، بيروت، ومطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، 1315ق، الهند. دار صادر ـ مصور من طبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدرآباد 1325 ق، الهند ـ بيروت.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جمال الدين يونس بن عبد الرحمان المزي(ت742ق)، تحقيق بشار عواد، مؤسسة الرسالة، 1409ق، ودار الملايين للعلم، بيروت.
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، محمد بن أحمد القرطبي (ت671ق)، تصحيح أحمد عبد العليم البردوني، ط1، دار إحياء التراث العربي، مطبعة الفجالة القديمة، مصـر.
حصـر الاجتهاد، آغا بزرك الطهراني(ت1389ق)، تحقيق محمد علي الأنصاري،1401هـ، مطبعة الخيام، قم المقدّسة.
حياة الإمام الحسين×، الشيخ باقر شريف القرشي، 1974م، مطبعة الآداب، النجف الأشرف.
خزانة الأدب، البغدادي(ت1093ق)، تحقيق محمد نبيل، إميل بديع يعقوب، ط1، 1998م، بيروت.
الخصال، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق)، ط5، 1400ق، مؤسسة الأعلمي، بيروت، ودار صادر، بيروت (بدون تاريخ)، والأعلمي، 1410ق.
خلاصة الأقوال في معرفة الرجال (رجال العلّامة الحلي)، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي(ت 726 ق)، تصحيح محمد صادق بحر العلوم، ط1، 1402ق، منشورات الشريف الرضي.
خلاصة عبقات الأنوار، حامد حسين النيشابوري الهندي.
الدر المنثور في التفسير المأثور، جلال الدين عبد الرحمان بن الكمال أبي بكر بن محمد السيوطي(ت911 ق)، أُفسيت المطبعة الإسلاميّة، 1377ق.
الدمعة الساكبة، ملا محمد باقر البهبهاني(ت 1285ق)، مؤسسة الأعلمي، 1409ه، بيروت.
ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، أحمد بن عبد الله (المحب الطبري) (ت694ق)، نشر حسام الدين القدسي، 1356ق، القاهرة.
ذخيرة المآل في شرح عقد الآل، أحمد بن عبد القادر بن بكري العجيلي الشافعي.
الذريعة إلى تصانيف الشيعة، محمد محسن (آقا بزرك الطهراني)، دار الأضواء، بيروت.
رأس الحسين، طاهر آل عكَلة، دار السلام، 1430هـ، بيروت.
ربع قرن مع العلّامة الأميني، حسين الشاكري، 1417هـ، ستارة.
رجال ابن داوُد، الحسن بن علي بن داوُد الحلي، المكتبة السلفيّة، 1402ق، المدينة المنورة.
رجال الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق جواد القيومي، مؤسسة النشـر الإسلامي، 1415ق، قم المقدّسة.
رجال النجاشي (فهرس أسماء مصنفي الشيعة)، أحمد بن علي بن أحمد النجاشي(ت 450 ق)، ط1، 1408ق، دار الأضواء، بيروت.
روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد باقر الخوانساري، مكتبة إسماعيليان، قم المقدّسة.
روضة الواعظين، محمد بن الحسن بن علي الفتال النيسابوري(ت508ق)، 1402ق، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1406ق، بيروت.
الرياض الزاهرة في فضائل آل بيت النبي وعترته الطاهرة، عبد الله بن محمد المطيري.
رياض العلماء وحياض الفضلاء، الميرزا عبد الله أفندي الأصفهاني(القرن الثاني عشر)، تحقيق أحمد الحسيني، مكتبة المرعشي النجفي، قم المقدّسة.
الرياض النضـرة في فضائل العشـرة، أحمد بن عبد الله (محب الدين الطبري الشافعي) (ت694 ق)، 1403ق، بيروت، ومصر.
سمط النجوم العوالي، في أنباء الأوائل والتوالي، عبد الملك بن حسين العصامي.
سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجة القزويني(ت275ق)، تحقيق فؤاد عبد الباقي، ط1، 1395ق، دار إحياء التراث، بيروت، ودار الفكر، 1371ق، بيروت.
سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت297ق)، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت.
سنن الدار قطني، علي بن عمر البغدادي الدار قطني(ت 285ق)، تحقيق أبي الطيب محمد آبادي، ط4، 1406ق، عالم الكتب، بيروت، وبولاق، القاهرة.
السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي(ت 458 ق)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي،1405ق، بيروت، وتحقيق محمد عبد القادر عطا، ط1، (مصورة من دائرة المعارف العثمانيّة حيدرآباد ـ الدكن، 1353ق)، 1414ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.
سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي(ت 748 ق)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط10، 1414ق، مؤسسة الرسالة، بيروت.
السيرة الحلبيّة (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون)، علي بن إبراهيم الحلبي الشافعي، دار الفكر العربي، 1400ق، بيروت.
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبو الفلاح عبد الحي (ابن العماد) (ت 1089ق)، تحقيق شعيب الأرنؤوط، 1409ق، بيروت، دمشق، ومكتبة القدسي، 1350ق، القاهرة.
شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد العيني(ت855ق)، مطبعة الفجالة الجديدة، 1376ق، مصـر.
شرح نهج البلاغة، عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي(ت656ق)، تحقيق محمد أبو الفضل، 1409ق، بيروت.
الشيعة وفنون الإسلام، حسن الصدر(ت1354ق)، مؤسسة السبطين،1427هـ، قم المقدّسة.
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري(ت256ق)، تحقيق مصطفى ديب البغا، ط4، 1410ق، دار ابن كثير، بيروت، ومطبعة المصطفائي، 1307ق.
صحيح الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت297ق)، 1405ق، بيروت، ومطبعة المكتبة السلفيّة، المدينة المنورة.
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت261ق)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، 1374ق، بيروت، ط1، 1412ق، دار الحديث، القاهرة، ودار إحياء التراث العربي، بيروت.
الصراط السوي في مناقب آل النبي، محمود الشيخاني القادري.
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، أحمد بن حجر الهيتمي الكوفي(ت 974ق)، إعداد عبد الوهاب بن عبد اللطيف، ط2، 1385ق، المطبعة الميمنيّة، مكتبة القاهرة، مصـر، وطبع المحمديّة، وطبع الحيدريّة.
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، محمد بن عبد الرحمان (الحافظ السخاوي) (ت902ق)، بيروت، ودار مكتبة الحياة، 1352ق، مطبعة القدسي، مصـر.
طبقات أعلام الشيعة، محمد محسن (آقا بزرك الطهراني)، ط2، دار التراث العربي، بيروت ـ لبنان، 1404 هـ.
طبقات الشافعية الكبرى، علي بن عبد الكافي السبكي(ت771ق)، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، محمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، وطبع عيسى البابي، 1383ق، مصر.
طبقات الشافعية، تقي الدين بن قاضي شهبة(ت851 ق)، تحقيق عبد العليم، خان ـ عالم الكتب، بيروت.
طبقات الشافعية، عبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي(ت771 ق)، تحقيق عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، 1396ق، القاهرة.
الطبقات الكبرى، محمد بن سعد الواقدي الزهري(ت230ق)، دار صادر، 1405ق، بيروت، وأوربا وليدن.
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، علي بن موسى بن طاووس (ت664ق)، ط1، 1400ق، مطبعة الخيام، قم المقدّسة.
الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، علي بن موسى بن طاووس (ت664ق)، مطبعة الخيام، 1399هـ، قم المقدّسة.
عبقات الأنوار، حامد حسين النيشابوري الهندي، الهند، وإيران.
العقد الفريد، أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسـي(ت 328ق)، تحقيق أحمد الزين، وإبراهيم الأبياري، ط1، 1408ق، دار الأندلس، بيروت، ومطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1948م، القاهرة.
عمدة الطالب، أحمد بن علي، بن عنبة (ت 828ق)، تصحيح محمد حسن، ط2، 1380هـ، الحيدريّة، النجف الأشرف.
عيون أخبار الرضا×، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (الصدوق) (ت381 ق)، منشورات المكتبة الحيدريّة، النجف الأشرف.
عيون الأخبار وفنون الآثار، عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة الدينوري) (ت276ق)، دار الكتاب العربي، وطبع قديم.
عيون التواريخ، محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي الشافعي، القاهرة.
الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، عبد الحسين أحمد الأميني(ت1390ق)، ط3، 1387ق، دار الكتاب العربي، بيروت، ودار إحياء الكتب العلميّة، 1402ق.
فتح الباري، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني(ت852 ق)، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، القاهرة، 1398ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت، والمطبعة السلفيّة، 1380ق، مصر.
فتوح البلدان، أحمد بن يحيى البلاذري(ت 279ق)، فهرسة صلاح الدين المنجد، مطبعة لجنة البيان العربي، مكتبة النهضة، 1956م، القاهرة.
الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي(ت314ق)، علي شيري،1411هـ، دار الأضواء.
فرائد السمطين في فضائل المرتضـى والبتول، والسبطين، والأئمّة من ذريتهم، إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن عبد الله الجويني الحمويني(ت 722) أو (730ق)، تحقيق محمد باقر المحمودي، مؤسسة المحمودي، 1398ق، بيروت.
الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، علي بن محمد المالكي المكي (ابن الصباغ) (ت855ق)، تحقيق سامي الغريري، 1422هـ، سرور، دار الحديث.
فضائل سيّدة النساء، عمر بن شاهين(ت385ق)، تحقيق الأثري، مكتبة التربية الإسلاميّة، 1411هـ، القاهرة.
فن الخطابة، محمد باقر المقدسي، معاصر، مؤسسة الإرشاد، 1429هـ، النجف الأشرف.
الفهرست، محمد بن إسحاق بن النديم، تحقيق ناهد عباس عثمان، ط1، 1985م، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة ـ قطر.
الفهرست، محمد بن الحسن الطوسي(ت460ق)، 1412ق، بيروت.
فوات الوفيات، محمد بن شاكر الكتبي(ت764ق)، تحقيق علي محمد، وعادل أحمد، 2000م، دار الكتب العلميّة، بيروت.
فيض القدير شرح الجامع الصغير، يحيى بن محمد عبد الرؤوف المناوي(ت1031ق)، ط1، 1356ق، القاهرة.
القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ط2، 1952م، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة.
قواعد تحقيق المخطوطات، صلاح المنجد، ط4، دار الكتاب الجديد، بيروت.
الكافي، محمد بن يعقوب الكليني الرازي(ت329ق)، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، 1389ق، طهران.
الكامل في التاريخ، علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الموصلي (ابن الأثير) (ت630ق)، تحقيق علي شيري، ط1، 1408ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي الجرجاني (ابن عدي) (ت365ق)، تحقيق لجنة من المختصّين، ط1، 1404ق، دار الفكر، بيروت.
كربلاء الثورة والمأساة، أحمد حسين يعقوب، ط1، 1418هـ، الغدير، بيروت.
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله (حاجي خليفة)، مكتبة المثنى، بغداد.
كشف الغمّة في معرفة الأئمّة، علي بن عيسى الإربلي(ت687ق)، تصحيح هاشم الرسولي المحلاتي، بيروت، ط1، 1401ق، ودار الكتاب الإسلامي، تبريز (بدون تاريخ).
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي(ت658ق)، تحقيق محمد هادي الأميني، ط2، 1404ق، دار إحياء تراث أهل البيت، طهران.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي(ت975ق)، تصحيح صفوة السقا، ط1، 1397ق، مكتبة التراث الإسلامي، بيروت، ودار الوعي، 1396ق، حلب.
الكنى والألقاب، عباس القمي، مكتبة الصدر، 1368ق، طهران.
لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصـري(ت711 ق)، ط1، 1410ق، دار صادر، بيروت.
لسان الميزان، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت852ق)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، ط1، 1416ق، دار الكتب العلميّة، بيروت.
ماضي النجف وحاضرها، جعفر باقر آل محبوبة، ط2، دار الأضواء، بيروت.
مثير الأحزان ومنير سبل الأشجان، محمد بن جعفر الحلي (ابن نما) (ت645ق)، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي، قم المقدّسة.
المجالس السنيّة، محسن الأمين العاملي، النجف الأشرف.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي(ت807 ق)، تحقيق عبد الله محمد درويش، ط1، 1412ق، دار الفكر، بيروت، وط2(بدون تاريخ)، القاهرة.
مدينة المعاجز، هاشم بن سليمان الحسيني البحراني التوبلي، مؤسسة المعارف الإسلاميّة، قم المقدّسة.
مرآة الجنان، عبد الله بن سعد اليافعي، دار صادر، 1405ق، بيروت.
مراصد الاطلاع، صفي الدين البغدادي(739هـ)، تحقيق محمد علي البجاوي، 1373هـ، دار المعرفة، بيروت.
مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين المسعودي(ت346ق)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط4، 1384ق، مطبعة السعادة، القاهرة.
المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ط1، 1411ق، دار الكتب العلميّة، بيروت، وطبع حيدرآباد.
مسند ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني(ت275ق)، تحقيق فؤاد عبد الباقي، نشـر دار الفكر، 1371ق، بيروت، ط1، 1395ق، دار إحياء التراث، بيروت.
مسند أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 241 ق)، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، ط2، 1414ق، دار الفكر، بيروت، وجامعة أُمّ القرى، ودار العلم، 1403ق، المملكة العربيّة السعوديّة.
المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني(ت211ق)، تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي، منشورات المجلس العلمي الأعلى، 1392ق، بيروت.
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، محمد بن طلحة الشافعي(ت654ق)، النجف الأشرف، ونُسخة خطيّة في مكتبة السيّد المرعشي النجفي.
معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء، محمد حرز الدين، مكتبة المرعشـي، 1405ق، الولاية، قم المقدّسة.
المعارف، عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة الدينوري) (ت276ق)، حقّقه وقدّم له ثروت عكاشة، ط1، 1415ق، منشورات الشـريف الرضي، قم المقدّسة.
المعجم الكبير، سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني(ت360ق)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، 1404ق، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا(ت395ق)، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404م.
المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد(الراغب الأصفهاني) (ت 468ق).
مقتل الحسين، الموفق محمد بن أحمد المكي الخوارزمي الحنفي(ت 568ق)، تحقيق محمد السماوي، مكتبة المفيد، طبع مطبعة الزهراء‘، قم المقدّسة.
مقتل الحسين، لوط بن يحيى الأزدي الكوفي(ت157ق)، ط2، 1364ق، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة.
الملحمة الحسينية، مرتضى المطهري، تحقيق عبد الكريم الزهيري، آينده درخشان، ط1، قم، 2009م.
مناقب آل أبي طالب، رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني(ت588ق)، المطبعة العلميّة، قم المقدّسة، والنجف الأشرف.
مناقب المغازلي، علي بن محمد بن محمد الواسطي الشافعي (ابن المغازلي) (ت483ق)، إعداد محمد باقر المحمودي، ط2، 1402ق، دار الكتب الإسلاميّة، طهران.
موسوعة كلمات الإمام الحسين×، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، قم المقدّسة.
النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير الشيباني الشافعي) (ت 509).
نهج البلاغة، محمد بن الحسين بن موسى الموسوي (الشـريف الرضي)، تنظيم صبحي الصالح، منشورات الإمام علي×، 1369ق، قم المقدّسة.
هدية العارفين (أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون)، إسماعيل باشا البغدادي(ت 1329ق)، طهران، أُفسيت من استانبول، 1369ق.
الوافي بالوفيات، صفي الدين خليل بن أيبك الصفدي، فرانز شتانيز ـ قيسبادان.
وسيلة المآل في عدّ مناقب الآل، أحمد بن محمد بن باكثير الحضـرمي (مخطوط).
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد البرمكي(ابن خلكان) (ت681ق)، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، 1398ق، بيروت.
وقعة صفّين، نصر بن مزاحم المنقري، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، ط2، القاهرة، ومكتبة السيّد المرعشي النجفي، 1382ق، قم المقدّسة.
ينابيع المودّة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي(ت1294ق)، تحقيق علي جمال أشرف الحسيني، ط1، 1416ق، دار الأُسوة، طهران، والمطبعة الحيدريّة، النجف الأشرف.
[1] الحج: آية6.
[2] (راموز الأحاديث/62، ط. استانبول، سنة 1275هـ).
[[3]][3] واعتزازاً بما خطّه قلمه الشريف رأينا أن نذكر كلمةً كتبها على غلاف مُسودة الكتاب، حيث جاء فيها: «قرأتُه ودعوتُ لجناب السيّد المحقق وفّقه الله».
وأذكر هنا بمجيئي لسماحته في وقت هو أعزّ وأشدّ ما يكون عليه من أوضاع صحية غير مستقرّة ـ نتمنى له الصحة والعمر المديد ـ وسط زحمة التأليف، وحيث لا يكاد يجد فرصة لإكمال مُصنفاته. وبالرغم من العلاقة المتينة التي تجمعنا معه إلّا أنِّي كنت لا أجرؤ على تكليفه بشيء لمقامه العالي، ومكانته الرفيعة، وهيبته المتناهية، وحبي له، ولكن الذي شجّعني على ذلك هو العلّامة المفدى السيّد عبد الستار الحسني، الذي وجّهني لالتماس سماحة السيّد إجازةً بالرواية، وقد نجحنا في ذلك إضافة لما خطّه قلمه المبارك في هذه الصفحة.
[4] وهي الفصل الثالث من الكتاب، المذكور تحت عنوان (نص الرسالة).
[5] تنبيه مهم من فضيلة الأُستاذ الدكتور حسن الحكيم (حفظه الله تعالى) في تغيير العنوان؛ ولكن لم نأخذ به؛ لئلا يقال إنَّ ما ذُكر عن المؤلف في مقدّمة التحقيق لا يصح أن يُصطلح عليه بـ (الدراسة)؛ إذ اقتصـر الحديث عنه في ترجمة ليست مُفصّلة ومُوسّعة، وكذلك صوناً للعنوان الذي وضعه المصنف، وحفاظاً على أمانة التراث.
[6]الجوس: طلب الشيء بالاستقصاء، وهو مصدر قولك: جاسوا خلال الديار، أي: تخللوها، فطلبوا ما فيها. وفي التنزيل: (فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا)(الإسراء:5)، أي: بينَ البُيُوتِ ووَسْطَ الدُّور. اُنظر: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج2، ص205.
[7] الناصِيَةُ: «قصاصٌ من الشَّعر في مقدّم الرأس». الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج7، ص159.
[8] التَّمَيُّسُ: التَّبخْتُرُ، يُقَال: ماسَ يَمِيسُ مَيْساً ومَيَسَاناً: تَبَخْتَرَ واخْتالَ. وفي حدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاء: «تَدْخُلُ قَيْساً وتَخْرُجُ مَيْساً، أَي: تَتَبخْتَرُ في مِشْيَتِها وتَتَثنَّى». اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص980.
[9] قشيبة: أي جديدة، وكلّ شيء جديد قشيب، ومنه سيف قشيب: حديث عهد بالجلاء. اُنظر: الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس: ج2، ص321.
[10] أي: لو نظر إليها، وهو من قولك شِمْتُ السَّحَابَ، أي: نَظَرْتُ أيْنَ يَقْصِدُ. وفي القصيدة الرائية المشهورة بالتترية: شاميةٌ لو شامَها قسُّ الفصاحة لافتخر. اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج6، ص293.
[11] الماتن في اصطلاح المؤلفين: واضع أصل الكتاب، وهو خلاف الشارح.
[12] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص24.
[13] المنجد، صلاح، قواعد تحقيق المخطوطات: ص15.
[14] قال الصولي: «تحرير الكتاب، خلوصه، كأنَّه خلُص من النُّسخ التي حرر عليها وصفاً عن كدرها». ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، أدب الكاتب: ج1، ص39. وقد يُطلق التحرير ويراد منه بعضٌ من مصاديق التحقيق، فقد يقال عن مخطوطة: «محتاجة إلى تحرير بعض معانيها، وإيضاح ما أشكل منها، وزيادات يُفتقر إليها، فحررت منها ما يجب تحريره، وأضفت إليها ما تتعين إضافته». اُنظر: ابن أبي الأصبع، عبد العظيم بن عبد الواحد، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر: ج1، ص82. وكذلك قد يُصطلح على الناسخ والكاتب بالمُحرر وفي يتيمة الدهر: ج2، ص229:
أقبح بخط مُحرر أقلامه لعنت أنامله إذا ما حررا
[15] وهو الذي يذكر في الهامش.
[16] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص306.
[17] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص326.
[18] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص106.
[19] المصدر السابق. البحراني، عبد الله، العوالم (الحسين): ص237.
[20] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص39.
[21] الطهراني، آغا بزرك، الذريعة: ج15، ص232.
[22] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج5، ص326.
[23] ابن العربي، أبو بكر، العواصم من القواصم: ص232.
[24] اُنظر: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ص220. وهل ما فعله يزيد ـ حين كان يضـرب ثغر الإمام الحسين× بقضيب ـ يُعدّ دليلاً على كمالات يزيد الخُلقية! «فدخلوا عليه، والرأس بين يديه، ومع يزيد قضيب، وهو ينكث به في ثغره... فقال رجل من أصحابرسولالله×، يقال له أبو برزة الأسلمي: أتنكث بقضيبك في ثغر الحسين، أَما لقد أخذ قضيبك من ثغره مأخذاً، لربما رأيت رسول الله| يرشفه، أَما إنَّك يا يزيد تجيء يوم القيامة، وابن زياد شفيعك، ويجيء هذا يوم القيامة ومحمد شفيعه، فقام وولى». ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج62، ص85.
[25] القاسم، أسعد وحيد، أزمة الخلافة والإمامة وآثارها المعاصرة: ص288ـ 289.
[26] الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب أمير المؤمنين×: ج2، ص156.
[27] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص656.
[28] المصدر السابق: ص165.
[29] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص149.
[30] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص30، بأسانيد من ترجمة الإمام الحسن× الرقم: 2619 ـ 2621.
[31] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص442.
[32] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج7، ص136.
[33] ابن شاهين، عمر بن أحمد، فضائل فاطمة‘: ص29.
[34] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج4، ص90.
[35] المناوي، محمد بن عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج4، ص121.
[36] الأحزاب: آية57.
[37] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص332.
[38] الدينوري، أحمد بن داوُد، الأخبار الطوال: ص254.
[39] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص91.
[40] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص39.
[41] آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة: ج1، ص447.
[42] المصدر السابق: ج15، ص232.
[43] ولكن مع ذلك لا بدّ من الاطلاع على مؤلفات السيّد حسن الصدر+، وخاصّة الكتب التي لها صلة بموضوع الكتاب، ونرى هل ورد ذكر فيها لهذه الرسالة؟ وهذا ما لم نوفّق إليه؛ لضيق وقت تحقيق هذه الرسالة. وكذلك يجب الاطّلاع على ما تركه السيّد عبد الحسين الكليدار خازن الروضة الحسينيّة؛ إذ له كتاب بعنوان: (بُغية النبلاء في تاريخ كربلاء)، وله جملة من المخطوطات ذكرها كلّ مَن ترجم له، عسى أن تكون فيه إشارة لهذه الرسالة.
[44] هذا النص ذكره محقق كتاب (توضيح الرشاد في تاريخ حصـر الاجتهاد لآغا بزرك الطهراني): ص6، ولكن عند الرجوع إلى كتاب (آداب اللغة العربية)، قال فيه جرجي زيدان ردّاً على الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في مراجعاته الريحانية على علماء الشيعة الإمامية بأنَّهم: «أكثرهم لن يخلّفوا آثاراً تُفيد المطالعين». زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية: ج3، ص6.
[45] اُنظر: الطهراني، آغا بزرك، توضيح الرشاد في تاريخ حصـر الاجتهاد: ص6. ما ذكره محققه في المقدّمة.
[46] آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة: ج15، ص232.
[47] ذرو: «هو الشيء اليسير من القول، كأنّه طرف من الخبر وليس بالخبر كلّه». ابن سلام، القاسم، غريب الحديث: ج3، ص474.
[48] آل طعمة: سادة ينتهي نسبهم إلى السيد إبراهيم المجاب، لها الصدارة من بين الأسر العلمية التي قطنت كربلاء، من أبرز رجالها السيد طعمة علم الدين الفائزي الموسوي، كما أنّ من أبرز رجالها المتأخرين السيد عبد الحسين الكليدار سادن الروضة الحسينية. اُنظر: آل طعمة، سلمان هادي، تراث كربلاء: ص93ـ 95.
[49] آل طعمة، سلمان هادي، تراث كربلاء: ص219.
[50] المصدر السابق.
[51] اسم الكتاب: الشبك من فرق الشيعة الغلاة.
[52] آل طعمة، سلمان هادي، تراث كربلاء: ص218. وقد ذكر السيّد سلمان الكتب التي ألفها السيّد عبد الحسين، ومنها: (تاريخ كربلاء المعلى)، طبع عام 1349هـ، و(بُغية النبلاء في تاريخ كربلاء)، وأمّا كتبه المخطوطة، فهي لدى أكبر أولاد المُترجم له السيّد عبد الصالح.
[53] الشهرستاني، صالح، شخصيات أدركتها: ص22.
[54] هكذا في الذريعة، والصحيح «الموسوي».
[55] آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، الذريعة: ج21، ص307.
[56] المصدر السابق: ج9، ص922.
[57] المصدر السابق: ج18، ص73.
[58] المصدر السابق: ج21، ص307.
[59] مؤسسة آل البيت، مجلة تراثنا: ج12، ص23.
[60] وقد حاولنا الاطّلاع عليها، ولكن لم نوفّق لذلك.
[61] كما نقل لنا سماحة الحجة المحقق السيّد عبد الستار الحسني.
[62] اُنظر: آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، الذريعة: ج4، ص411.
[63] لقد رأيت ـ وأنا أُثبّت ما أشار له
العلّامة المحقق السيّد محمد رضا الجلالي (حفظه الله) من تصحيح في هذا الكتاب ـ
ملاحظةً أعتزّ بذكرها، وهي عن مصطلح (السيادة)، وقد أثبتُّ اسمي بدونها، وهو مما
اعتاد عليه بعضٌ، وهنا كَتَب سماحة العلّامة المحقق كلمة (السيّد) قبل اسمي،
وأضاف: (حبيبي لا تترك (السيادة) مع اسمك الكريم، فإنَّه فخر وشرف. والحمد ِلله
ربِّ العالمين على هبته ما شاء لَمن شاء،
(وَأَمَّا
بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)
(الضحى:11).
[64] شاهدة الصور من خلال الرابط التالي :
الصفحة الأولى من المسودة : https://admin.warithanbia.com/files/images/1254971723_1694251007.jpg
الصفحة الثانية من المسودة : https://admin.warithanbia.com/files/images/987768675_1694250979.jpg
الصفحة الأخيرة من المسودة : https://admin.warithanbia.com/files/images/1281121179_1694250983.jpg
الصفحة الأولى من المبيضة : https://admin.warithanbia.com/files/images/1226988724_1694250988.jpg
الصفحة الأخيرة من المبيضة :
https://admin.warithanbia.com/files/images/996144664_1694250992.jpg
الصفحة الأولى من المصححة : https://admin.warithanbia.com/files/images/954766807_1694250997.png
الصفحة الأخيرة من المصححة : https://admin.warithanbia.com/files/images/1756022772_1694251001.jpg
الصفحة الأولى من المطبوعة : https://admin.warithanbia.com/files/images/1235280685_1694251004.jpg
[65] في (بُغية الراغبين في أحوال آل شرف الدين)، وذكرت الترجمة في مقدّمة (تكملة أمل الآمل).
[66] اُنظر: مقدمة كتاب الشيعة وفنون الإسلام.
[67] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج5، ص326.
[68] وذُكرت ترجمته في مقدّمة كتاب (نزهة الحرمين في عمارة المشهدين (مشهد أمير المؤمنين ومشهد الحسين)) للسيّد حسن الصدر+، وقد ذكر السيّد شرف الدين تعريفاً ووصفاً لهذه الترجمة المهمّة، فقال: «وبعد وفاته (أعلى الله مقامه) ترجمه الشريف العلّامة المتتبع الثبت الحجة السيّد على النقي النقوي، ترجمةً مفصّلةً علّقها على رائيته العصماء العامرة، التي رثى بها السيّد، وقد جرى في الترجمة مجرى الشرح لتلك الرائية العبقرية، فكانت ترجمةً ضافيةً جامعةً مثّلت أدوار حياته العلميّة والعمليّة، منذُ ولد حتى اختار الله له دار كرامته. وتناولت ذكر الأعلام من آبائه عَلماً عَلماً حتى انتهت إلى شرف الدين... واستقصت سائر الأبطال من مُتقدمي هذه الأُسرة ومتأخريها، ممّن هم في جبل عامل، أو في العراق، وذكرتهم بطلاً بطلاً بما هم أهله من جلالة القدر، وعلو المنزلة في الدين والدنيا، وأرّخت وفياتهم، وتصدت لبيان مكانة السيّد في العلم، ومنزلته في الأُمّة، وذكرت شيوخه الذين أخذ عنهم، وكثيراً من الشيوخ الذين أخذوا عنه، وأتت على مصنفاته في سائر العلوم والفنون، واشتملت على ذكر وفاته وتشييعه، ومآتمه التي انعقدت في العراق، وعاملة، وإيران، والهند، وغيرها».
[69] المرعشي، شهاب الدين، المسلسلات في الإجازات: ج2، ص100.
[70] آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة: ج1، ص447.
[71] النجفي، محمد حرز الدين، معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: ج1، ص249.
[72] الصدر، حسن، الشيعة وفنون الإسلام: (مقدّمة الناشر).
[73] وهو الدينار المسكوك من الذهب، يُسمّى أشرفي بالفارسي في ذلك الزمان. اُنظر: الحائري، مرتضـى، شرح العروة الوثقى: ج2، ص165.
[74] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص422 ـ 427.
[75] والسيّد المُترجَم له (حسن الصدر) من آل شرف الدين، إلّا أنَّه اشتُهر بالصدر نسبة إلى عمّ والده. اُنظر: آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، طبقات أعلام الشيعة: ج1، ص447.
[76] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص13. مقطع من ترجمة المؤلف بقلم السيد شرف الدين.
[77] مرهف: «رقيق، ومرهوف البدن، أي: لطيف الجسم دقيقه. وأكثر ما يقال: مرهف الجسم، وسيف مرهف ورهيف، أي: محدد». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج 9، ص128.
[78] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص14.
[79] المصدر السابق.
[80] المصدر السابق: ص161.
[81] المصدر السابق.
[82] (بذَّ) «الباء والذال أصل واحد، وهو الغلبة والقهر والإذلال. يقال: بذَّ فلان أقرانه، إذا غلبهم، فهو باذ يبذهم». ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص177. «بذَّ فلان فلاناً يبذّه بذّاً، إذا ما علاه وفاقه في حسن، أو عمل كائناً ما كان، وأخطأ مَن قال: بزَّ فلان أقرانه». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص477. «بزه يبزه بزاً: سلبه. وفى المثل: مَن عزّ بزّ، أي: مَن غلب أخذ السلب». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج6، ص2280. «بزا عليه يبزو، أي: تطاول». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص865.
[83] السيّد الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص14.
[84] المصدر السابق: ص15.
[85] قال في الصحاح: «مثل يُضرب للفرس، وللرجل إذا كان لسانه يثبت في موضع الزلل والخصومة». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص766. «ورجل ثبت الغدر، أي: ثابت في قتال أو كلام، وأصل الغدر: الموضع الكثير الحجارة، والصعب المسلك، لا تكاد الدابة تتخلص منه، فكأنَّ قولك: غادره، أي: تركه في الغدر، فاستعمل ذلك حتى يقال: غادرته، أي: خلّفته». الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج4، ص390.
[86] قال في العين: «وفلان شديد العارضة، أي: ذو جلد وصرامة». الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج1، ص276. «قيل للثنايا التي تظهر عند الضحك: العوارض، وفلان شديد العارضة: كناية عن جودة بيانه». المناوي، محمد عبد الرؤوف، التعاريف: ج1، ص511.
[87] قال الراغب: «وغرب السيف لغروبه في الضريبة، وهو مصدر في معنى الفاعل، وشُبّه به حدّ اللسان كتشبيه اللسان بالسيف، فقيل: فلان غرب اللسان». الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات غريب القرآن: ص359.
[88] «غور كلّ شيء: قعره. يقال: فلان بعيد الغور». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص33. والمعنى هنا إنَّ حجته عميقة الغور، لا يمكن إدراكها ومجاراتها والرد عليها، أي: كالماء الغائر الذي لا يُقدر عليه.
[89] قال في المعجم: «القحف العظم فوق الدماغ والجمع أقحاف». ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة: ج5، ص61. «رميته بسكاته، أي: بما أسكته». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج1، ص253.
[90] اقتباس من قول الأنصاري في سقيفة بني ساعدة، وصار مثلاً يُضرب به لَمن يكون مرجعاً، ويُعتمد على رأيه. «أنا جذيلها المحكك: هو تصغير جذل، وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به، وهو تصغير تعظيم، أي: أنا ممن يُستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود. أراد أنَّه يُستشفى برأيه كما تستشفي الإبل الجربى باحتكاكها بالعود المحكك: وهو الذي كثر الاحتكاك به. وقيل: أراد أنَّه شديد البأس صلب المكسر، كالجذل المحكك». «وعذيقها المرجب، الرجبة: هو أن تعمد النخلة الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها أن تقع. ورجبتها فهي مرجبة. والعذيق: تصغير العذق بالفتح، وهي النخلة، وهو تصغير تعظيم، وقد يكون ترجيبها بأن يجعل حولها شوك؛ لئلا يُرقى إليها، وقيل: أراد بالترجيب التعظيم. يقال رجب فلان مولاه: أي عظّمه. ومنه سمّي شهر رجب، لأنَّه كان يُعظّم». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص251، وص418، وج2، ص197.
[91] ذُكرت لهم ـ وكذلك لَمن سيأتي ذكره من تلامذته ـ تراجم مختصرة في معارف الرجال للشيخ محمد حرز الدين، ومفصّلة في أعيان الشيعة للسيّد محسن العاملي.
[92] الأنطاكي، محمد مرعي، لماذا اخترت مذهب أهل البيت: ص67.
[93] اُنظر: آغا بزركَ الطهراني، محمد محسن، مقدّمة حصر الاجتهاد.
[94] لقمان: آية11.
[95] الكهف: آية109.
[96] «ربط لذلك الأمر جأشا، إذا حبس نفسه وصبّرها، وهو رابط الجأش وربيط الجأش، وهذا فعيل بمعنى مفعول. والجأش في الأوّل في معنى المفعول، وفى الثاني معنى الفاعل». الزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث: ج2، ص14.
[97] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص42، (ترجمة المؤلف بقلم السيد شرف الدين).
[98] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج5، ص325.
[99] النجفي، محمد حرز الدين، معارف الرجال في تراجم العلماء والأدباء: ج1، ص249.
[100] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص40.
[101] الريحاني، أمين، ملوك العرب:ج2، ص273.
[102] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص45.
[103] آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، نقباء البشر: ج1، ص445.
[104]«الأكر: (بضم الهمزة وفتح الكاف) جمع كرة ـ على لغة ـ وهي كلّ جسم مستدير... أكر: الأكرة (بالضم): الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء، فيغرف صافياً... ويقال: أكرت الأرض، أي: حفرتها، ومن العرب مَن يقول للكرة التي يلعب بها: أكرة، واللغة الجيدة الكرة». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص26.
[105] الصدر، حسن، انتخاب القريب من التقريب، تحقيق الدكتور ثامر كاظم الخفاجي: ص25، نقلاً عن المسلسلات في الإجازات: ج2، ص100.
[106] الصدر، حسن، تكملة أمل الآمل: ص56.
[107] حقّقه حفيده السيّد عادل السيّد عبد الصالح الكليدار آل طعمة، وطبع منه الجزء الأوّل، والجزء الثاني قيد الإعداد.
[108] «العقر في أرض بابل، خرج فيها يزيد بن المهلب عن البصرة في جموع كثيفة عظيمة، فالتقوا بابل فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقُتل يزيد وعدّة من إخوته في جمع من أهل العراق، وانهزم الباقون، وذلك في سنة (102هـ)». المسعودي، علي بن الحسين، التنبيه والإشراف: ص278.
[109] ابن العربي، أبو بكر، العواصم من القواصم: ص232.
[110] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص306.
[111] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج10، ص14.
[112] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص302. وقد ورد لفظ (السكوني) في بعض المواضع من كتاب الصحيح من مقتل سيّد الشهداء وأصحابه، وذكر أيضاً ترجمة له في: ص1257. ولم ينتهِ إلى نتيجة واضحة في الفرق بينهما، وسيأتي تفصيل ذلك.
[113] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص382. اُنظر: الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج13، ص56.
[114] السماوي، محمد، أبصار العين: ص42.
[115] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص320.
[116] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج2، ص834.
[117] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص177.
[118] المصدر السابق: ص547.
[119] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص62.
[120] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص305.
[121] الفاضل الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص43، وقال في الذريعة: ج2، ص279 عن المؤلف: «ومن شدّة خلوصه وصفاء نفسه نقل في هذا الكتاب أُموراً لا توجد في الكتب المعتبرة، وإنَّما أخذها عن بعض المجاميع المجهولة، اتكالاً على قاعدة التسامح في أدلة السنن، مع أنَّه لا يصدق البلوغ عنه بمجرد الوجادة بخط مجهول، وقد تعرّض شيخنا في اللؤلؤ والمرجان إلى بعض تلك الأُمور فلا نطيل بذكرها».
[122] المصدر السابق: ج3، ص39.
[123] الميرزا النوري، حسين، اللؤلؤ والمرجان: ص168.
[124] الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج1، ص663.
[125] المقدسي، محمد باقر، فن الخطابة: ص162.
[126] الدربندي، آغا بن عابد، إكسير العبادات في أسرار الشهادات: ج3، ص43.
[127] اُنظر: المطهري، مرتضى، الملحمة الحسينيّة: ج1، ص14وما بعدها.
[128] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص178.
[129] الفيروزآبادي، مرتضى، فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج3، ص286.
[130] أحصى مصادره السيّد المرعشي في تعليقات على إحقاق الحق: ج11، ص319 ـ 324، ومن أشهرها: المستدرك على الصحيحين: ج3، ص178، وفي التلخيص أيضاً. كنز العمال: ج12، ص127. الجامع لأحكام القرآن: ج10، ص219. الدر المنثور: ج4، ص264. تاريخ بغداد: ج1، ص152. تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص225، وج64، ص216. سير أعلام النبلاء: ج4، ص342. البداية والنهاية: ج8، ص219. تهذيب الكمال: ج6، ص431. ذخائر العقبى: ص150. تهذيب التهذيب: ج2، ص305. لسان الميزان: ج4، ص457. ومصادر أُخرى كثيرة للعامّة.
[131] النمازي، علي، مستدرك سفينة البحار: ج3، ص242. وكذا اُنظر: الأربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمّة: ج2، ص63. القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص168. ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص81. ابن طاووس، علي بن موسى، الطرائف في معرفة مذهب الطوائف: ص202. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى: ج1، ص429. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، كشف اليقين: ص306. وهناك مصادر أُخرى للخاصّة.
[132] الإسراء: آية15.
[133] الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج1، ص212.
[134] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص234.
[135] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج45، ص49. المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج21، ص359. المتقي الهندي، علي، كنز العمال: ج13، ص674. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص242.
[136] الدينوري، أحمد بن داوُد، الأخبار الطوال: ص260.
[137] آل عكَلة، طاهر، رأس الحسين×: ص113.
[138]«واقصة: موضع في طريق مكة إلى العراق». الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج5، ص354.
[139] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص72.
[140] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف: ص52.
[141] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص90.
[142] وهو صاحب شرطته، وتقدّم أنَّ الصحيح هو (الحصين بن تميم بن أُسامة بن زهير بن دريد التميمي). و(الطهوي) إمّا نسبة لأحد أجداده، أو هو تصحيف، وفي جميع الروايات أنَّه عقد له على أربعة آلاف وأرسله إلى القادسية، وكان تحت إمرته الحرّ بن يزيد الرياحي.
[143] ابن سعد، محمد، الطبقات (ترجمة الإمام الحسين×): ص70.
[144] ابن الصباغ المالكي، علي بن محمد، الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ص819.
[145] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص598.
[146] تقدّمت الإشارة إلى اسمه الصحيح.
[147] هكذا في المصدر، والصحيح واحد وعشرين ألفاً، أو أنّ محقّق الفصول (سامي الغريري) وجد شخصاً آخر جاء بألف، ولكن نسي أن يذكره، فقد ورد أنّ شبث بن ربعي خرج بألف.
[148] ابن الصباغ، علي بن محمد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص818 ـ 820.
[149] اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج3، ص99. الدنيوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص254 وما بعدها. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص36 ـ 37. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص95. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص33. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج 33، في ترجمة الحسين×. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص320 وما بعدها.
[150] وهو بن تميم التميمي.
[151] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص386، وج45، ص10 وما بعدها. الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين: ج1، ص242. البلخي، أحمد بن سهل، البدء والتاريخ: ج6، ص10. ابن شهرآشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج2، ص215. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج4، ص342 وما بعدها. المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج2، ص60 وما بعدها. الحصـري، إبراهيم بن علي، زهر الآداب: ج1، ص134. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص36. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج6، ص261. ابن عبد ربّه، أحمد بن محمد، العقد الفريد: ج4، ص379. الحسيني، محمد بن الحاج، شرح شافية أبي فراس: ص137، اليعقوبي، أحمد، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص217. أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين: ص114، وما بعدها.
[152] وعلى رواية الشيخ المفيد يكون الحرّ قد وصل في الثاني من المُحرّم، أي: نزل كربلاء مع الإمام الحسين×، وأمّا عمر بن سعد يكون وصوله في اليوم الثالث من المحرّم؛ لأنَّه قال: «نزل الحسين× في يوم الخميس وهو اليوم الثاني من المُحرّم فلمّا كان الغد قدم عليهم عمر بن سعد».
[153] وكان مع الإمام علي× في وقعة صفّين على عمرو الكوفة وحنظلتها. اُنظر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج4، ص27. العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص147.
[154] هكذا ورد نسبه في الطبقات، اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات: ج6، ص231.
[155] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص386.
[156] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص264.
[157] وفي رواية الطبري: الحر بن يزيد الرياحي، وهو خطأ واضح.
[158] وهو الحصين بن تميم.
[159] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص78.
[160] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ص166.
[161] «ثمَّ قال عمر بن سعد لقرّة بن سفيان الحنظلي: انطلق إلى الحسين، فسله ما أقدمك؟ فأتاه فأبلغه». الدنيوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص253.
[162] العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص82.
[163] عبد الله بن زهير بن سُليم بن مخنف العامري. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص39.
[164] تقدّم الحديث عن لقبه وترجمته.
[165] «رجلاً من بني تميم». ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص39.
[166] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص321.
[167] يعقوب، أحمد حسين، كربلاء الثورة والمأساة: ص301.
[168] المصدر السابق.
[169] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص104.
[170] المصدر السابق.
[171] المصدر السابق.
[172] البحراني، عبد الله، العوالم: ص293.
[173] المنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفين: ص291. والمحجف: لابس الحجفة، وهى ترس يُتخذ من جلود الإبل.
[174] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص333.
[175] ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص182.
[176] المصدر السابق، وص279.
[177] ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص39.
[178] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج1، ص198.
[179] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص254.
[180] ابن الجوزي، عبد الرحمن، تذكرة الخواص: ص314.
[181] العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري:
ج7، ص656. والغريب أنَّه لم يرضَ بتغيير العدد حتى عكس الأسماء، فجعل الرئيس الحرّ،
وهو كان قائداً تحت إمرة الحصين،
وهو بن تميم التميمي.
[182] ابن سعد، محمد، الطبقات (ترجمة الإمام الحسين×): ص70.
[183] اُنظر: المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج3، ص61.
[184] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص118.
[185] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص254.
[186] ابن مزاحم، نصر، وقعة صفّين: ص141.
[187] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص95.
[188]«المناظر: جمع المنظرة: القوم يصعدون إلى أعلى الأماكن ينظرون ويراقبون ما ارتفع من الأرض أو البناء». البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص180.
[189]«المسالح: جمع المسلحة: المرقب أو قوم ذوو السلاح يحرسون ويراقبون». المصدر السابق.
[190]«مقدحة من قولهم: قدح الفرس، ضمّره. أي: صيّره هزالاً خفيف اللحم؛ كي يكون عند الجري سريعاً يسبق أقرانه إلى الهدف». المصدر السابق.
[191] المصدر السابق، ص179.
[192] «العرفاء: جمع عريف، وهو القيّم بأُمور القبيلة أو الجماعة من الناس، يلي أُمورهم ويتعرّف الأمير منه أحوالهم». «المناكب: قوم دون العرفاء، واحدهم: منكب. وقيل: المنكب: رأس العرفاء. وقيل: أعوانه. والنكابة: كالعرافة والنقابة». ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3، ص218، وج5، ص113.
[193] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص178.
[194] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص254، وفي رواية أُخرى: إنَّ ابن زياد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث، وأمر القعقاع بن سويد بن عبد الرحمان بن بجير المنقري بالتطواف بالكوفة في خيل، فوجد رجلاً من همدان قد قدِم يطلب ميراثاً له بالكوفة، فأُتى به ابن زياد فقتله، فلم يبقَ بالكوفة مُحتلم إلّا خرج إلى العسكر بالنُّخيلة.
[195] ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص36.
[196] المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج1، ص375.
[197] المصدر السابق: ج3، ص60.
[198] المصدر السابق: ج3، ص61.
[199] الدينوري، أحمد بن داوُد، الأخبار الطوال: ص254.
[200] «ثمَّ إنَّ الحسين× لمّا علم أنَّهم مقاتلوه، سأل عمر بن سعد المهادنة، وترك القتال بواحدة من ثلاث: أن يرجع إلى موضعه الذي جاء منه، أو يمضى إلى بعض البلاد يكون كأحدهم، أو يمضى إلى يزيد فيرى فيه رأيه. فقال عمر بن سعد: أخاف أن تُهدم داري». ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص36.
[201] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص313.
[202] المصدر السابق: ص342.
[203] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص76.
[204] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص257. وهناك رواية أُخرى ذكرها الخطيب الإبراهيمي، وفيها أنَّه قال لهم: «تقدموا... لأُرزء بكم»، فحرّفت إلى (لأرثكم). ولم أعثر على مصدر قوله. «والرزء والمرزئة والرزيئة: المصيبة، والجمع أرزاء ورزايا. وقد رزأته رزيئة، أي: أصابته مصيبة. وقد أصابه رزء عظيم». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص86.
[205] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج4، ص79.
[206] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص248.
[207] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص89.
[208] الشورى: آية23.
[209]البيت للشاعر أبي محمد عبد السلام بن رغبان المعروف بـ (ديك الجن)، أصله من مؤتة، وولد في حمص. انظر: القمي، عباس، الكنى والألقاب: ج2، ص212. شبر، جواد، أدب الطفّ: ج1، ص288.
[210] «سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف، حولها مدينة تطيف بها، وهي بدمشق، في وسطها كالمحلة باب الجامع الشـرقي إليها يُسمّى باب جيرون، وقيل: جيرون قرية الجبابرة في أرض كنعان». صفي الدين، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ج1، ص366.
[211] «السنّور: حيوان أليف من الفصيلة السنّورية ورتبة اللواحم، من خير مآكله الفأر، ومنه أهلي وبري، وهي سنّورة». مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج1، ص454.
[212] «بفسطاط مصر». صفي الدين، عبد المؤمن بن عبد الحق، مراصد الاطّلاع: ج2، ص756.
[213]«القدس: السطل بلغة أهل الحجاز؛ لأنَّه يُتطهر فيه». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج6، ص169.
[214] القاضي الكراجكي، محمد بن علي، التعجب من أغلاط العامّة في مسألة الإمامة: ص117.
[215] البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان: ج2، ص343.
[216] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص293. بل لا يستبعد اشتراك بعض النصارى واليهود مع جيش عمر بن سعد؛ إذ ذكروا عن (حجار بن أبجر) أنَّ أباه كان نصرانياً، مات على النصـرانيّة بالكوفة، فشيّعه بالكوفة النصارى لأجله، والمسلمون لأجل ولده إلى الجبانة.
[217] يعقوب، أحمد حسين، كربلاء (الثورة والمأساة): ص34.
[218] شمس الدين، محمد مهدي، أنصار الحسين: ص58.
[219] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص339.
[220] المصدر السابق: ص335.
[221] المنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفّين: ص166.
[222] المصدر السابق: ص205.
[223] المصدر السابق: ص117.
[224] المصدر السابق: ص149.
[225] المصدر السابق: ص152.
[226] المصدر السابق: ص292.
[227] المصدر السابق: ص330.
[228] المصدر السابق: ص403.
[229] المصدر السابق: ص558.
[230] المصدر السابق: ص336.
[231] المصدر السابق: ص290.
[232] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ص167.
[233] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص332.
[234] وهناك بحث آخر في هذا المجال، وهو فيما يتعلّق في ولاء القبائل، وهو ليس من صلب الموضوع، ونذكر له شاهداً مما ذكره الشيخ محمد مهدي شمس الدين في أنصار الحسين: ص200، قال: «نلاحظ أنَّ بعض النصوص تُشير إلى دور بارز قامت به بعض عناصر عرب الشمال، وهم القيسيون، في مساندة السلطة لقمع الثورة الحسينيّة. نذكر في هذا المجال بما تقدّم من أنَّ القوة التي قبضت على مسلم بن عقيل كانت من قيس. وثمّة نصّ شعري عظيم القيمة يُضئ الموقف القبلي، فهو يُبيّن أنَّ قيساً هي الغريم الأكبر مسؤولية في قتل الحسين: قال سليمان بن قته المحاربي التابعي من جملة شعر له في رثاء الحسين:
|
وإنَّ قتيل الطفّ من آل هاشم |
|
أذلّ رقاب المسلمين فذلت |
|
وعند غني قطرة من دمائنا |
|
سنجزيهم يوماً بها حيث حلّت |
|
إذا افتقرت قيس جبرنا فقيرها |
|
وتقتلنا قيس إذا النعل زلت |
فالشاعر في رثائه للحسين يذكر قيساً (قيس عيلان بن مضر) ويذكر غنياً (من غطفان، من قيس عيلان) ويُحملهما مسؤولية مقتل الحسين، ويهدد بالانتقام».
[235] «الربع: المحلّة. يقال: ما أوسع ربع فلان». الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج3، ص1211. «والربع: المنزل والوطن، متى كان، وبأي مكان كان، كلّ ذلك مشتق من ربع بالمكان يربع ربعاً... والربع: جماعة الناس. وقال شمر: الربوع: أهل المنازل». الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس: ج11، ص131.
[236] اُنظر: البراقي، حسين بن أحمد، تاريخ الكوفة: ص135.
[237] من شعراء العراق، ولد سنة (1309ه) في الشطرة، وتعلم في النجف، وعُيّن قاضياً لمحكمة البصـرة سنة (1933م)، واختير رئيساً لمجلس التمييز الشرعي الجعفري، وأصبح من أعضاء مجلس الأعيان، توفي سنة(1384ه). اُنظر: الخاقاني، علي بن جعفر، تاريخ الكوفة: هامش ص163.
[238] اُنظر: البراقي، حسين بن أحمد، تاريخ الكوفة: ص161. نقلاً عن مجلة الاعتدال: مجلد4، ج1، ص41.
[239] البراقي، حسين بن أحمد، تاريخ الكوفة: ص163.
[240] لعلّه أراد أحد أرباع مدينة الكوفة، وهو الذي ممّن لم ينتظم في قبيلة، أو الذين سكنوا وسطها بعد خط سعد بن أبي وقاص لنزار وأهل اليمن في الجانب الشرقي، وصارت خطط نزار في الجانب الغربي.
[241] البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان: ج2، ص338.
[242] البراقي، حسين بن أحمد، تاريخ الكوفة: ص225.
[243] اُنظر: البراقي، حسين بن أحمد، تاريخ الكوفة: ص226.
[244] هذه الكلمة لم ترد في النُّسخ المخطوطة؛ وآثرنا ذكرها ـ وإن كان الحديث فيها لا يتعدى أسطر معدودة ـ تمييزاً لمِا ذكره المصنف فيها، ولأنَّنا اتخذنا منهجاً في ذكر العناوين التي ذكرها المصنف في هامش الُمسودَّة ضمن متن الرسالة، وقد ذكر المصنف بعد كلمة مصابهم آية: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (الشعراء:227)، ثمَّ عدل عنها وذكر في محلّها الكلمات التي جاءت بعدها.
[245] في (ب): والعن أعدائهم أجمعين، وقبلها (وبه ثقتي) من (ص).
[246] السائل هو السيّد عبد الحسين، خازن الحضـرة الحسينيّة، وتقدّمت ترجمته، وسيأتي ثناء المؤلف عليه، ووصفه بالسيّد (الأجل) في خاتمة الرسالة. اُنظر: آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، الذريعة: ج15، ص232.
[247] (تاريخ الأُمم والملوك) المعروف بـ(تاريخ الطبري).
[248] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص309، وسيذكر المؤلف ما ورد في تاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير، عن قدوم عمر بن سعد، والمُخرَجين معه لحرب الإمام الحسين× في الطفّ.
[249] تقدّم تحقيق ما ذكره علماء الشيعة في عدد المُخرَجين في مقدّمة التحقيق.
[250] ذكرها المصنف في الهامش وثُبّتت في (ب) و(ص).
[251] في (م) و(ب): فأقول وبالتوفيق.
[252] في (ب): فمَن يحضرني.
[253] نسبة لمدينة (نصيب)، وتقع على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، وبينها وبين الموصل ستة أيّام، وبين سنجار تسعة فراسخ. اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج5، ص288.
[254] هكذا في جميع النُّسخ، وفي إحدى نُسخ المصدر أيضاً، وفي المطبوع منه (رأوه)، وهو الأنسب في مقابلة (رووه).
[255] ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص356. «... ومنه حديث على (إنِّي لأُسرِّبه عليه)، أي: أرسله قطعة قطعة».(والأسراب من الناس: الأقاطيع). ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص463.
[256] «أطلاب جمع طالب...أي: أهل الطلب». ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج1، ص560. «وعن ابن الأعرابي، الطلبة: الجماعة من الناس». الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس: ج2، ص185.
[257] الشافعي، محمد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ص381. تحقيق ماجد أحمد عطية. ورأيت أن أذكر هنا تتمّة كلامه التي فيها دلالة واضحة على صدق المؤلف وإخلاصه لأهل البيت^، ورزئه بما جرى عليهم، فقال: «فلمّا حصروه وأحدقوا به، شاكين في العدّة والعديد، ملتمسين منه نزوله على حكم ابن زياد أو بيعته ليزيد، فإن أبى ذلك فليؤذن بقتال يقطع الوتين وحبل الوريد، ويُصعِدُ الأرواح إلى المحل الأعلى، ويصـرع الأشباح على الصعيد، فتبعت نفسه الأبية جدّها وأباها، ونادته النخوة الهاشمية فلباها، ومنحها الإجابة إلى مجانبة الذلّة وحباها، فاختار مجالدة الجنود ومضاربة ضباها، ومصادمة صوارمها، وشيم شباها، ولا يذعن لوصمة تسم بالصغار من شرفه خدوداً وجباهاً...».
[258] اليافعي، عبد الله بن أسعد، مرآة الجنان وعبرة اليقظان: ج2، ص188.
[259] الهندي، حامد حسين، خلاصة عبقات الأنوار: ج8، ص238.
[260] الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن، طبقات الشافعية: ج2، ص503، ومما جاء في ترجمته: (ترسّل عن الملوك، وأقام بدمشق بالمدرسة الأمينيّة، وعيّنه الملك الناصر صاحب دمشق للوزارة، وكتب تقليده بذلك، فنصل منه واعتذر، فلم يقبل منه، فباشرها يومين، ثمَّ ترك أمواله وموجوده، وغيَّر ملبوسه وذهب، فلم يُعرف موضعه. سمع وحدّث. وتوفّي بحلب في السابع والعشـرين من رجب سنة (652هـ). وقد جاوز السبعين. ذكره في العبر مختصراً).
[261] السبكي، عبد الوهاب بن علي، طبقات الشافعية: ج5، ص26.
[262] حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون: ج2، ص1152. وقال عن موضوع كتاب (العقد الفريد): «جعله على أربعة قواعد: الأوّل: في مهمات الأخلاق والصفات. الثاني: في السلطنة والولايات. الثالث: في الشـرايع والديانات. الرابع: في تكملة المطلوب بأنواع من الزيادات».
[263] اُنظر: الصفدي، خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات: ج3، ص17. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج11، ص44. الذهبي، محمد بن أحمد، العبر: ج5، ص213. الكتبي، محمد بن شاكر، عيون التواريخ: ج20، ص78. السبكي، عبد الوهاب بن علي، طبقات الشافعية الكبرى: ج8، ص63. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج13، ص186. الأتابكي، يوسف، النجوم الزاهرة: ج7، ص33. ابن العماد، عبد الحي، شذرات الذهب: ج5، ص259. ابن الغزي، محمد بن عبد الرحمان، ديوان الإسلام: ج1، ص61. الطباخ، محمد راغب، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: ج4، ص437. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج23، ص293. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون: ج1، ص734. البغدادي، إسماعيل بن محمد، هدية العارفين: ج1، ص96. الحسيني، أحمد بن محمد، صلة التكملة: ج2، ص11. الأميني، عبد الحسين، الغدير: ج5، ص413. مقدّمة كتابه مطالب السؤول.
وذكر إسماعيل باشا البغدادي بعض مؤلفاته، فقال: «الحفار ... من تصانيفه: تحصيل المرام في تفضيل الصلاة على الصيام، الجفر الجامع، ومصباح النور اللامع، الدر المنظم في الاسم الأعظم، زبدة المصنفات في الأسماء والصفات، زبدة المقال في فضائل الأصحاب والآل، العقد الفريد للملك السعيد، مطالب السؤول في مناقب الرسول|، مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح، نفائس العناصر لمجالس الملك الناصر (أعني: صلاح الدين) وغير ذلك». البغدادي، إسماعيل بن محمد، هدية العارفين: ج2، ص125. ومن كتبه المهمّة (الجفر)، وكتابه (الدر المنظّم في الاسم الأعظم)، ذكر فيه خطبة البيان للإمام علي×، ونسخة منه في المكتبة الرضوية في مشهد المقدّسة.
[264] الجملة ذكرها المصنف للتوضيح.
[265] اُنظر: ابن الصباغ، علي بن محمد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة (المطبوع): ج2، ص818: «وجنّد الجنود»، وقال المحقق في الهامش: «في (ب، د): وحشد وحشود».
[266] «فخرج عمر إلى الحسين×». ابن الصباغ، علي بن محمد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة (المطبوع): ج2، ص819.
[267] «شيئاً بعد شيء». المصدر السابق.
[268] في جميع النُّسخ رُسمت هكذا: «ثلثين ألف» وهو خطأ نحوي؛ إذ بعد صفحة من (ص) رسمها هكذا (ثلثون) ومراده (ثلاثون)، وفي الفصول المهمّة: ج2، ص818. «عشـرون ألف»، ولم يذكر المحقق فيما إذا كان عدد آخر لنُسخ أُخرى.
[269] ابن الصباغ، علي بن محمد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص819.
[270] اللكهنوي، حامد حسين، خلاصة العبقات: ج8، ص250.
[271] (العجيلي) وعنوان كتابه: (ذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللآل في مناقب الآل). وهو شرح لمنظومته المسماة بـ(عقد جواهر اللآل). المصدر السابق: ج8، ص361.
[272] عبد الله بن محمد المدني، والمطيري شهرة، الشافعي مذهباً، وعنوان كتابه: (الرياض الزاهرة في فضل آل بيت النبي وعترته الطاهرة)، وهو ممن اعتمد كتاب (الفصول المهمّة)، وقال عن كتابه: «جمعت فيه ما اطّلعت عليه مما ورد في هذا الشأن، واعتنى بنقله العلماء العاملون الأعيان، وأكثره من الفصول المهمّة لابن الصباغ...». المصدر السابق: ج8، ص250.
[273] وهو نور الدين السمهودي، وعنوان كتابه: (جواهر العقدين في فضل الشرفين، شرف العلم الجلي والنسب العلي). خلاصة ترجمته من الضوء اللامع للسخاوي، وكانت ولادته سنة (844هـ)، وتوفّي سنة (911هـ). المصدر السابق: ج1، ص280.
[274] ذكر ترجمته من خلاصة الأثر للمحبي، قال: «ولد بمصر في سنة (975هـ)، وألّف المؤلفات البديعة، منها: السيرة النبويّة التي سمّاها (إنسان العيون في سيرة النبي المأمون)، في ثلاثة مجلدات، اختصرها من سيرة الشيخ محمد الشامي، وزاد أشياء لطيفة الموقع، وقد اشتُهرت اشتهاراً كثيراً... وكانت وفاته سنة (1044هـ)». المصدر السابق: ج8، ص369.
[275] في النُّسخ (فصول المهمّة)، وفي (ط) ذكر في الهامش أنَّ الصحيح (الفصول المهمّة)، وما ثُبّت لعلّه الأنسب في سياق الجملة، ولم نضع معقوفتين حول (الهاء) احترازاً للمعنى.
[276] ومنهم الشيخاني القادري في (الصراط السوي)، وأيضاً ذكر كتابه السخاوي في الضوء اللامع: ج4، ص303. فقال: «وله مؤلفات، منها: الفصول المهمّة لمعرفة الأئمّة، وهم اثنا عشر».
[277] في النُّسخ المخطوطة (عتبة) وهكذا رُسمت في (ط)، والمشهور كما ثُبّت في المتن، وقال محقق عمدة الطالب: (وما كُتب على النُّسخة الخديوية من الأغلاط، كذكرها في نسبه أنَّه حسيني وهو حسنى بلا خلاف، وأنَّه ابن عنبسة بالسين، وهو المعروف بابن عنبة بالباء بلا ريب، كما أنَّ ابن عتبة بالتاء الفوقانية في مطبوعة بمباي من أغلاطها الكثيرة... قال الزبيدي في تاج العروس بمادة (عنب): «عنبة الأكبر: جدُّ قبيلة من أشراف بنى الحسن بالعراق ونواحي الحلة»، وهو مؤرخ نسّابة مشهور، توفّي سنة (828 هـ) اُنظر: ترجمته ومصنفاته في: آغا بزرك الطهراني، محمد محسن، الضياء اللامع في القرن التاسع. القمي، عباس، الكنى والألقاب: ج1، ص355. الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج1، ص177. البغدادي، إسماعيل بن محمد، هدية العارفين: ج1، ص123.
[278] حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون: ج2، ص1167.
[279] وممّن اعتمد على كتابه من العامّة: العصامي في (سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي)، ووصفه في: ج2، ص390. بـ(العلّامة السيّد النسيب، والشريف الحسيب، أبو جعفر شهاب الدين، أحمد بن علي بن مهنا الداودي الموسوي).
[280] «منعوه من المسير». في (ب) والمصدر المطبوع.
[281] ابن عنبة، أحمد بن علي، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص190.
[282] من تاريخ الأُمم والملوك، وهو تكملة ما رواه عن أبي مخنف.
[283] «دستبى: بفتح أوّله... والباء الموحدة والألف المقصورة... كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهمذان، فقسم منها يُسمّى (دستبى الرازي)، وهو يقارب التسعين قرية، وقسم منها يُسمّى (دستبى همذان)، وهو عدّة قرى، وربما أُضيف إلى قزوين في بعض الأوقات لاتصاله بعملها». الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص454.
[284] من (م) و(ص) وهو الموافق للمصدر خلافاً لمِا في (ب): «فكتب إليها».
[285] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص309. وهذه الفقرة استدركها المصنف في الهامش.
[286] هكذا في جميع النُّسخ والمصدر. وفي الكامل لابن الأثير: (الجعفي)، وتقدّم الحديث عن لقبه (الحنفي)، وسيأتي أنَّه مُصحّف عن (الجعفي).
[287] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص320. والرواية عن أبي مخنف، عن فضيل بن خديج الكندي، عن محمد بن بشر، عن عمرو الحضرمي. وقد تقدّم تحقيق قوله: (وعلى ربع تميم وهمدان الحرُّ بن يزيد الرياحي)، فإنّ أكثر الروايات تذكر أنَّ الحصين بن تميم هو الذي كان عليهم، والحرّ بن يزيد كان تحت إمرته.
[288] أي: الطبري في تاريخه، وإسناده: «عن أبي مخنف، عن جميل بن مرثد من بني معن، عن الطرمّاح بن عدي».
[289] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص306. وإسناده: «عن أبي مخف، عن جميل بن مرثد من بني معن، عن الطرمّاح بن عدي». «فكيف وظاهر الكوفة مملوء بالخيول والجيوش يُعرضون ليقصدوك...». ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص188. اُنظر: العصامي، عبد الملك بن حسين، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: ج2، ص78. وهناك شاهد آخر لهذه الكثرة التي تجمعت في الكوفة في حديث عبيد الله بن الحرّ الجعفي، «فأرسل الحسين إليه بعض مواليه يأمره بالمصير إليه، فأتاه الرسول، فقال: هذا الحسين بن علي يسألك أن تصير إليه. فقال عبيد الله: والله، ما خرجت من الكوفة إلّا لكثرة مَن رأيته خرج لمحاربته، وخذلان شيعته...». الدينوري، أحمد بن داوود، الأخبار الطوال: ص250.
[290] من (ص) واستدركها المصنف في (م)، ولم ترد في (ب).
[291] من (م) و(ب)، وسقطت من (ص).
[292] بهم: من (م) و(ب).
[293] في النُّسخ وفي(ط): (العديب) بالدال المهملة، وما ثُبّت هو المشهور، وهو (عذيب الهجانات): موضع فوق الكوفة عن القادسية أربعة أميال، وهو حدّ السواد كما سيأتي.
[294] (يكن): سقطت من (ب).
[295] تقدّم في المقدّمة أنَّ (الحصين بن تميم التميمي) كان أحد قادة جيش ابن زياد على الرماة في واقعة كربلاء، كما ذكر الشيخ المفيد في الإرشاد: ج2، ص104. «ولمّا بلغ ابن زياد مسير الحسين من مكة بعث الحصين بن نمير(تميم) التميمي، صاحب شرطته، فنزل القادسية، ونظّم الخيل ما بين القادسية إلى خفّان، وما بين القادسية إلى القطقطانة وإلي جبل لعلع» و«كان مجيء الحرّ من القادسية، أرسله الحصين بن نمير(تميم) التميمي في هذه الألف يستقبل الحسين». ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص41، و ص46. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص302.
[296] هكذا في الأصل.
[297] اليافعي، عبد الله بن أسعد، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان: ج2، ص188. قال: «فبعث عبيد الله بن زياد ابن أبيه خيلاً، وأمّر عليهم أميراً سمّوه من أولاد بعض الصحابة أكره ذكره، فأدركه بكربلاء، وما زال عبيد الله بن زياد يزيد العساكر إلى أن بلغوا (اثنين وعشرين ألفاً»، ووعد الأمير المذكور أن يُملّكه مدينة الري، فباع الفاسق الرشد بالغيّ وفيه يقول:
|
|
أم أرجع مأثوماً
بقتل حسين |
قلت ولو قال:
|
أأترك ملك الري
بل هو بغيتي |
|
وإن عُدت
مأثوماً بقتل حسين |
لكان هذا الإنشاد أدلّ على المراد، فضيّق عليه الفاسق أشدّ تضييق، وسدّ بين يديه واضح الطريق إلى أن قتله... بقرب الكوفة بموضع يقال له كربلاء.
[298] من (م) و(ب)، وفي (ص): (لاسبقى) وهو تصحيف. وفي (ط): (الدستبي).
[299] واسمه الحصين بن تميم التميمي، وتقدّمت الإشارة عن اسمه الصحيح، وسيأتي بعد أسطر بأنَّه السكوني وهو خطأ، وستأتي ترجمته. واختلفوا في العدد الذي أقبل معه، والمشهور (أربعة آلاف)، من غير (ألف) الحرّ الذي أرسله لملاقاة الإمام الحسين×.
وفي رواية ابن سعد في طبقاته: عقد له عبيد الله على (ألفين)، ووجّهه إلى عمر بن سعد مدداً).
[300] في (ب): الذين، وما ذكر من (م) و(ص) وهو الأصح، بدليل الضمير العائد من صلة الموصول، وهو مفرد.
[301] في (ب): أربعة.
[302] هذه الفقرة ذكرها المصنف في هامش (المُسوَّدة)، ووضع لها علامة تتبع ما ذكره في هامش الصفحة السابقة، وكذلك وضع علامة في نهايتها تُشير إلى الكلام الذي سيأتي بعدها، وهو قوله: وقد صرّح محمد بن أبي طالب، وورد هذا التنظيم في (ص)، ولكن في (ب) ذكر فقرة (فتحصّل) بعد قوله: فقد صرّح محمد بن أبي طالب على ما حكاه في البحار: إنَّ الجمع والتحشيد كان بعد خروج عمر بن سعد، ثمَّ بعد أن ذكرها عاد وأكمل بقيّة قول محمد بن أبي طالب، وسبب اشتباه الناسخ أنَّ المصنف ترك سطراً بعد أن وضع خطاً عليه دلالة على تركه، فاعتقد أنَّ هامش (فتحصّل) يأتي هنا، وهذا خطأ واضح في تنظيم الفقرات.
[303] في (ب): ابن سعد.
[304] من تسلية المجالس والبحار، وفي (ب): يحسن، وفي فتوح ابن أعثم الكوفي: ج5، ص89 ـ الذي روى النصّ مختصراً مع اختلاف في ألفاظه، وقد تقدّم ذكره ـ: (محسن) المطابق لما في (م) و(ص) على أنَّه معطوف على خبر (أنَّه) والتي وردت في المطبوع بسقوط الهاء وبقاء (أنَّ) بعد (عرفتموه).
[305] هكذا في النُّسخ، وفي مجالس محمد بن أبي طالب: «ويغنيهم بالأموال»، ولم تُذكر في الفتوح.
[306] ذكر ابن شهر آشوب أسماءً لهم في المناقب، وهم: الأوّل: مضاير بن رهينة المازني، والثاني: نصـر بن حرشة، وأمّا الحصين فقد تقدّمت الإشارة إلى اسمه الصحيح، وهو الحصين بن تميم بن أُسامة بن زهير بن دريد التميمي.
[307] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص385.
[308] من (م) و(ب)، وفي (ص): «بجمعهم الناس»، وهو ما اختاره في (ط).
[309] وهذه البعوث لم تقتصر على الناس الذين رآهم الطرمّاح في ظهر الكوفة، بل جاءت بعضها من النُّخيلة؛ إذ كان فيها عرض آخر للجيش أشرنا له في المقدّمة، وورد ذكره في تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص326. ولعلّ هذا العرض حصل على الرواية التي تقول: إنَّ عبيد الله بن زياد عسكر في النُّخيلة بعد أن استخلف عمرو بن حريث على الكوفة، وجاء فيه: «قال أبو مخنف: حدّثني أبو جناب قال: كان منّا رجل يُدعى عبد الله بن عمير، من بني عُليم، كان قد نزل الكوفة واتخذ عند بئر الجعد من همدان داراً، وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسط، يقال لها: أُم وهب بنت عبد، فرأى القوم بالنُّخيلة يُعرضون ليُسرّحوا إلى الحسين، قال: فسأل عنهم؟ فقيل له: يُسـرحون إلى حسين بن فاطمة بنت رسول الله|. فقال: والله، لو قد كنت على جهاد أهل الشـرك حريصاً، وإنِّي لأرجو ألّا يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت نبيهم أيسر ثواباً عند الله من ثوابه إيّاي في جهاد المشـركين، فدخل إلى امرأته، فأخبرها بما سمع، وأعلمها بما يُريد. فقالت: أصبت، أصاب الله بك أرشد أُمورك، افعل وأخرجني معك. قال: فخرج بها ليلاً حتى أتى حسيناً، فأقام معه...».
[310] وأكد ذلك الدينوري في الأخبار الطوال: ص254، قال: «ثمَّ وجّه الحصين بن نمير(تميم)، وحجار بن أبجر، وشبث بن ربعي، وشمر بن ذي الجوشن؛ ليعاونوا عمر بن سعد على أمره».
[311] «عبد الله بن عبد الملك المسعودي: من ذرية ابن مسعود (رضي الله عنه) شيعي فيه كلام... قال العقيلي: كان من الشيعة، وفيه نظر...». ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج2، ص49. «قيل: كان معتزلي العقيدة». السبكي، عبد الوهاب بن علي، طبقات الشافعية: ج3، ص300. وأمّا ما ذكره علماء الشيعة، فمنهم: الحر العاملي حيث قال في أمل الآمل: ج2، ص180: «علي بن الحسين بن علي المسعودي، أبو الحسن الهذ لي، له كُتب في الإمامة... منها: كتاب في إثبات الوصية لعلي بن أبي طالب×، وهو صاحب مروج الذهب، قاله العلّامة. وذكره النجاشي، وقال: له كتاب المقالات...». وجاء في مقدّمة إثبات الوصية: «وعلى هذا فلا موقع لمِا في لسان الميزان، وحيث لم يتحققه السبكي نسبه إلى القيل». اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج15، ص569. الصفدي، صلاح الدين، الوافي بالوفيات: ج6، ص362.
[312] (نص) رسمت في النُّسخة المحقّقة هكذا (نصٌّ)، وليس لها معنى واضح في العبارة، والصحيح (الذي نُصَّ على أنَّه له)، أي: نصَّ صاحب فوات الوفيات والنجاشي والحلي، على أنَّ كتاب (إثبات الوصية) للمسعودي صاحب مروج الذهب.
[313] الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات: ج2، ص81.
[314] النجاشي، أحمد بن علي، رجال النجاشي: ص254.
[315] العلّامة الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال: ص186.
[316] ذكر بعض المؤرخين توجّه عبيد الله إلى جهة كربلاء، ومنهم: ابن سعد، فذكر أنَّه خرج وعسكر بالنُّخيلة، فقال: «وقال لشمر بنِ ذي الجوشن: سرْ أنت إلى عمر بن سعد، فإن مضـى لمِا أمرته وقاتل حسيناً، وإلّا فاضرب عُنقه، وأنت على الناس. قال: وجعل الرجل والرجلان والثلاثة يتسلّلون إلى حسينٍ من الكوفة، فبلغ ذلك عبيد الله، فخرج فعسكر بالنُّخيلة، واستعمل على الكوفة عمرو بن حريث، وأخذ الناس بالخروجِ إلى النُّخيلة، وضبط الجسـر، فلم يترك أحداً يجوزه. وعقد عبيدُ الله لحصين بن تميم الطهوي(التميمي) على (ألفينِ)، ووجّهه إلى عمر بن سعد مدداً له. وقدِم شمر بن ذي الجوشن الضبابي على عمر بن سعد بمَا أمرَه به عبيدُ الله عشية الخميس لتسع خلون من المُحرّم سنة إحدى وستين بعد العصر». ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (طبقات ابن سعد): ص69. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ص179. قال: «ثمَّ إنَّ ابن زياد استخلف على الكوفة عمرو بن حريث، وأمر القعقاع بن سويد بن عبد الرحمن بن بجير المنقري بالتطواف بالكوفة في خيل...».
[317] المسعودي، علي بن الحسين، إثبات الوصية: ص176.
[318] تقدّم ذكر النصّ الذي ذكره المسعودي في مروج الذهب: ج1، ص374. في حديث واقعة كربلاء، ولم نجد في الكتب التي ترجمت للمسعودي ما ذهب إليه السيّد حسن الصدر+ في قوله: «أنَّه صنّفه بمصـر لبعضِ مَن لا يسعه ذكر كلّ شيء»، بل قال الميرزا النوري في خاتمة المستدرك: ج3، ص310: «ولم يُطعن عليه إلّا في تصنيف مروج الذهب، وليس بشـيء، إذ هو بمرأى من هؤلاء ومسمع، والمتأمل في خباياه يستخرج ما كان مكتوماً في سريرته، فإنَّه ذكر من مناقب أمير المؤمنين× المقتضية لأحقيته بالخلافة شيئاً كثيراً، كحديث المنزلة، والطير، والغدير، والإخوة)، ثمَّ ذكر الميرزا خطبة للإمام علي ذكرها في المروج، وهي عند ذكر (المبدأ وشأن الخليقة)، وفي كيفية انتقال أنوار الأئمّة عبر الأصلاب، ومما جاء في آخر الخطبة: «ثمَّ انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أئمّتنا، فنحن أنوار السماء، وأنوار الأرض، فبنا النجاة، ومنّا مكنون العلم، وإلينا مصير الأُمور، وبمهدينا تنقطع الحجج، خاتمة الأئمّة، ومنقذ الأُمّة، وغاية النور، ومصدر الأُمور فنحن أفضل المخلوقين، وأشرف الموحدين، وحجج ربّ العالمين، فليهنأ بالنعمة مَن تمسّك بولايتنا وقبض عروتنا».
[319] في التذكرة: الري وخوزستان.
[320] سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة خواص الأُمّة في خصائص الأُئمّة: ص314، وقصته ذكرها أكثر المؤرخين، ومنهم: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص310.
[321] ما بين المعقوفتين من المصدر، وجاء في محلّها في النُّسخ: «فقال عمر بن سعد» ولم ترد في الأصل.
[322] «ذلك». ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص53.
[323] علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص52.
[324] علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص 52، وفي النُّسخ (ثلاثة عشر).
[325] المصدر السابق: ج4، ص91، وهذا الشاهد الذي ذكره المؤلف من كامل ابن الأثير، أراد منه أن يذكر جملة من أسماء القبائل، وقادتهم وليس مراده الحصر فيما ذكره.
[326] لقد تقدّم الحديث عن أسماء بطون هذه القبائل وأعدادها، ونذكر مثالاً لها في (مذحج)، وهي خمسة وأربعون بطناً، وقد قال المسعودي في مروج الذهب: ج1، ص374. عن قبيلة مراد في حديثه عن هانئ بن عروة المذحجي المرادي الغطيفي: «كان شيخ مراد وزعيمها، يركب في أربعة آلاف دارع، وثمانية آلاف راجل، فإذا تلاها أحلافها من كندة ركب في ثلاثين ألف دارع». ومن الأعداد التي تُذكر في هذاالمجال ما جاء في قول الطرمّاح الشاعر حين طلب من الإمام الحسين× أن يذهب معه إلى بلاد قومه حتى يرى رأيه، وأن ينزل جبلهم (أجاء) وتكفل له بعشـرين ألف طائي، يضربون بين يديه بأسيافهم.
[327] «لما غلب أهل الشام على الفرات... أتى (الأشعث) علياً من ليلته، فقال: يا أمير المؤمنين، أيمنعنا القوم ماء الفرات وأنت فينا، ومعنا السيوف... فقال: ذاك إليكم. فرجع الأشعث، فنادى في الناس: مَن كان يُريد الماء أو الموت فميعاده الصبح، فأتاه من ليلته اثنا عشـر ألف رجل» وفي نسخة: «فأتاه اثنا عشر ألفاً من كندة، وأفناء قحطان واضعى سيوفهم على عواتقهم». المنقرى، نصر بن مزاحم، وقعة صفّين: ص166.
[328] وهو (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد بن منيع، أبو عبد الله البصري الزهري، المولود سنة (158هـ).
[329] اُنظر: المنقرى، نصر بن مزاحم، وقعة صفّين: ص166.
[330] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص258. ورواية محمد بن أبي طالب ذكرها المجلسـي مع اختلاف يسير، اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص385. اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص134.
[331] (آلاف) سقطت من (باء) و (ط).
[332] لم ترد هذه الرواية في تاريخ الطبري، وجاء في: ج4، ص348: «فقُتل من أصحاب الحسين× (اثنان وسبعون) رجلاً، ودَفن الحسينَ وأصحابَه أهلُ الغاضرية من بنى أسد بعد ما قُتلوا بيوم، وقُتل من أصحاب عمر بن سعد (ثمانية وثمانون رجلاً) سوى الجرحى». ولا شكّ أنَّ الرواية محرّفة، وأمّا ما ذكره السيّد حسن الصدر+ في هذه الرواية، فقد وقع سهواً وأراد أن يذكر كتاب (إثبات الوصية)، فهو الذي ورد فيه هذا العدد، وتقدّمت الإشارة عنه في المقدّمة. ولا شكّ في وقوع الكرامات في يوم عاشوراء على يد الإمام الحسين×؛ حتى تكون حجةً ودليلاً وبرهاناً على أنَّه× من أهل البيت، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، ولكن هذا العدد وهو (ألف وثمانمائة رجل)، أو العدد الذي ذكره ابن شهر آشوب ليس فيه ما يدلّ على أنَّه حصل على نحو الإعجاز والكرامة ـ وإن كان الوقت الذي استغرق قتل هذا العدد ساعات معدودة ـ وإنَّما هو إظهار لشجاعته وقوته؛ لئلا تُثار حوله شبهات الأُمويين من الخوف والجبن والضعف، وعلاوةً على ذلك أنَّه قتل هذا العدد، وهو في حال الدفاع عن نفسه، إذ لم يكن همّه أن يبدأهم بقتال، أو يكون متابعاً في الهجوم عليهم بعد أن يشدَّ فيهم، ولهذا كان بعد أن «يشدّ عليهم بسيفهِ، فينكشفونَ عنه انكشافَ المعْزى إذا شدَّ فيها الذئبُ» يرجعُ إلى مركزِه، وهو يقولُ: لا حولَ ولا قوةَ إلّا باللهِ العلي العظيم. ثمَّ لم يكن أيضاً هدفه أن يقتل أكثر عدداً منهم؛ إذ كان بهم رحيماً عطوفاً، فبكى على ما صدر عنهم، وما قاموا به من أعمال؛ لأنَّهم سيدخلون النار بسببه، فهذا العدد هو من الأعداد الواقعية التي تُصدّقه الروايات التاريخية، وأمّا رواية أسرار الشهادة التي تقدّم ذكرها في المقدّمة من أنَّه× قتل (اثني عشر ألفاً)، فلم ترد في الكتب المعتبرة، ثمَّ هي تدلّل على أنَّ مهمّة الإمام الحسين× هي إبادة ذلك الجيش ـ والحال أنَّ الهدف من واقعة كربلاء المقدّسة هو إحياء النفوس وليس إبادتها، وهداية العقول وليس القضاء عليها، فهي امتداد لتلك المعارك التي سبقتها (الجمل، وصفّين، والنهروان)، وأعتقد أنَّ ذكر هذا الرقم هو إساءة لرحمة الإمام الحسين× وشفقته على القوم ـ وتُصوّر همّه القتل وسفك الدماء، وإن كان يجوز له× شرعاً قتل جميع ذلك الجيش فيما لو قتلوا رجلاً واحداً من أصحابه، كما قال الإمام علي× عن أصحاب الجمل:«فوالله، لو لم يُصيبوا من المسلمين إلّا رجلاً واحداً مُتعمّدين لِقَتْله بلا جُرم جرّه، لحلّ لي قتل ذلك الجيش كلّه؛ إذ حضروه فلم يُنكروا ولم يدفعوا عنه بلسان ولا يد». خطب أمير المؤمنين ×، نهج البلاغة: ج2، ص85. وقد تقدّم ما ذكره سماحة الشيخ المقدسي عن هذا العدد في المقدّمة فراجع.
[333] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص70. الفتال النيسابوري، محمد بن الحسن، روضة الواعظين: ص189. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص111. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص302. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص345.
[334] تقدّم ذكر الرواية عنهم^، والأُخرى عن ثابت بن أبي صفيّة في مقدّمة التحقيق تحت عنوان (آراء الشيعة في عدد المُخرَجين لحرب الحسين×). وعمّا ورد عن الأئمّة^ في هذا العدد، قال أحمد حسين يعقوب في (كربلاء الثورة والمأساة: ص42): «ومن المؤكّد بأنَّ الأئمّة الكرام إذا حدّثوا، فإنِّما يُحدّثون عن رسول الله، ورسول الله لا ينطق عن الهوى، فكافة المعلومات التي يثبت صدورها عن أئمّة أهل بيت النبي هي معلومات يقينية من جميع الوجوه».
[335] وفي كتب التراجم ذكروا ابنه (الصقعب)، وأنَّه خال المؤرخ
أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي، وأخوه العلاء، وهما من رواة العامّة. وفي مثير
الأحزان: ص39. (عبد الله بن زهير بن سليم العامري)،
وهو خطأ.
[336] ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص44.
[337] لم نجد في كتب الرجال عروة بن قيس، والظاهر أنَّ الصحيح عزرة بن قيس. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، هامش ص38. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص353. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص158. وهو عزرة بن قيس بن عزية الأحمر البجلي الدهني الكوفي.
[338] (حجار بن أبجر البكري) نسبة لقبيلته بكر بن وائل. اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج3، ص103. (أبو أسيد البكري العجلي الكوفي). ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ دمشق: ج12، ص205.
[339] وجدّه يزيد بن رويم كان على ذهل الكوفة مع الإمام علي× في صفّين، ويزيد بن الحارث هو أحد مَن كلّمهم الإمام الحسين× في يوم عاشوراء، كما في المقاتل: «فنادى: يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث...». «وعزم مصعب على توجيه المهلب، وأن يشخص هو لحرب عبد الملك. فلمّا أحس به الزبير، خرج إلى الري ـ وبها يزيد بن الحارث بن رويم ـ فحاربه، ثمَّ حصـره، فلمّا طال عليه الحصار خرج إليه، فكان الظفر للخوارج، فقُتل يزيد بن الحارث بن رويم، ونادى يزيد ابنه حوشبا، ففرّ عنه وعن أُمّه لطيفة ـ وكان علي بن أبي طالب× دخل على الحارث بن رويم يعود ابنه يزيد، فقال: عندي جارية لطيفة الخدمة أبعث بها إليك، فسمّاها يزيد لطيفة ـ فقُتلت مع بعلها يزيد يومئذٍ». ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج4، ص165.
[340] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج 24، ص434. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج5، ص349. اُنظر: الجاحظ، عمرو بن سحر، البيان والتبيين: ج1، ص46 ـ 47. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء: ج2، ص585 ـ 590. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، الأغاني: ج12، ص35 ـ 45، وهامش ص213.
[341] ابن ماكولا، علي بن هبة الله، الإكمال: ج6، ص315.
[342] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج5، ص540.
[343] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج10، ص175.
[344] ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص34.
[345] ومن هذا الرأي ما ذكره الحائري في معالي السبطين: ج1، ص276، وذكر رأيين في اسمه، فقال: (الطرمّاح بن عدي، وقيل: الطرمّاح بن الحكم) أراد ابن (حكيم)، والصحيح كما ذُكر في المتن.
[346] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص246. الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الخوارزمي: ج1، ص23. ابن نما الحلي، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص24. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص95. القمي، عباس، نَفَس المهموم: ص153.
[347] ابن أبي الحديد، حميد، شرح نهج البلاغة: ج10، ص14.
[348] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ دمشق: ج14، ص388.
[349] الريشهري، محمد، الصحيح من مقتل سيّد الشهداء وأصحابه: ص1257.
[350] هؤلاء الثلاثة، وهم: (الوليد بن عمرو، وهلال الأعور، وعيهمة بن زهير)، ذكرهم الدينوري بهذه الأسماء في الأخبار الطوال: ص259، ولم يرد لهم ذكر في كتب التراجم.
[351] وهؤلاء الثلاثة، وهم: (كعب بن طلحة، ومضاير بن رهينة، ونصر بن حرشة)، ذكرهم ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب: ج3، ص248. وورد ذكرهم: (كعب بن طلحة، والمصاب الماري، ونصر بن حربة)، عند ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص79. ولم نستطع التعرّف على تراجمهم؛ للتصحيف الذي طرأ على أسمائهم كما (المصاب الماري) أصبح (مضاير المازني)، وفي (حرشة) ورد (حرشنة) و(حربة).
[352] الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج1، ص271.
[353] الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج1، ص121.
[354] المصدر السابق.
[355] ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث: ج4، ص153.
[356] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص345.
[357] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص204. وكذا: ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث: ج4، ص152. واُنظر: ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (طبقات ابن سعد): ص74. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص345.
[358] الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص454.
[359] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، فتوح البلدان: ج2، ص338.
[360] اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص379.
[361] اُنظر: المصدر السابق: ص78.
[362] اُنظر: الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج4، ص374.
[363] اُنظر: المصدر السابق: ج5، ص18.
[364] الحربي، عاتق بن غيث، معجم المعالم الجغرافية: ص319.