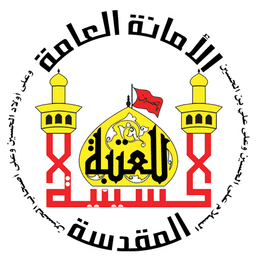إنّ نشر المعرفة، وبيان الحقيقة، وإثبات المعلومة الصحيحة، غاياتٌ سامية وأهدافٌ متعالية، وهي من أهمّ وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت على عاتقها تنفيذ هذه الوظيفة المقدّسة.
من هنا؛ قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإنشاء المؤسّسات والمراكز العلمية والتحقيقية؛ لإثراء الواقع بالمعلومة النقية؛ لتنشئة مجتمعٍ واعٍ متحضّر، يسير وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.
وممّا لا شكّ فيه أنّ القضية الحسينية ـ والنهضة المباركة القدسية ـ تتصدّر أولويات البحث العلمي، وضرورة التنقيب والتتبّع في الجزئيات المتنوّعة والمتعدّدة، والتي تحتاج إلى الدراسة بشكلٍ تخصّصي علمي، ووفق أساليب متنوّعة ودقيقة، ولأجل هذه الأهداف والغايات تأسّست مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، وهي مؤسّسة علميّة متخصّصة في دراسة النهضة الحسينية من جميع أبعادها: التاريخية، والفقهية، والعقائدية، والسياسية، والاجتماعية، والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة المرتبطة بهذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكفّل بدراسة سائر ما يرتبط بالإمام الحسين×.
وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق هذه المؤسّسة المباركة؛ كونها مختصّة بأحد أهمّ القضايا الدينية، بل والإنسانية، فقد قامت بالعمل على مجموعة من المشاريع العلمية التخصّصية، التي من شأنها أن تُعطي نقلة نوعية للتراث، والفكر، والثقافة الحسينية، ومن تلك المشاريع:
1 ـ قسم التأليف والتحقيق: والعمل فيه جارٍ على مستويين:
أ ـ التأليف، والعمل فيه قائم على تأليف كتبٍ حول الموضوعات الحسينية المهمّة، التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما ويتمّ استقبال الكتب الحسينية المؤلَّفة خارج المؤسّسة، ومتابعتها علميّاً وفنّياً من قبل اللجنة العلمية، وبعد إجراء التعديلات والإصلاحات اللازمة يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق، والعمل فيه جارٍ على جمع وتحقيق التراث المكتوب عن الإمام الحسين× ونهضته المباركة، سواء المقاتل منها، أو التاريخ، أو السيرة، أو غيرها، وسواء التي كانت بكتابٍ مستقل أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (الموسوعة الحسينيّة التحقيقيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على متابعة المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ لجمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتم استقبال الكتب التي تم تحقيقها خارج المؤسسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها وإدخال التعديلات اللازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في المؤسسة.
2 ـ مجلّة الإصلاح الحسيني: وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية، والفقهية، والأدبية، في تلك النهضة المباركة.
3 ـ قسم ردّ
الشبهات عن النهضة الحسينية: ويتمّ فيه جمع الشبهات المثارة حول الإمام الحسين×
ونهضته المباركة، ثمّ فرزها وتبويبها، ثمّ الرد عليها بشكل علمي تحقيقي.
4 ـ الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×: وهي موسوعة تجمع كلمات الإمام
الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية،
ووضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام×
والواقع العلمي.
5 ـ قسم دائرة معارف الإمام الحسين×: وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالنهضة الحسينية من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء أعلام وأماكن، وكتب، وغير ذلك من الأُمور، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، ومكتوبةٌ بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ سلس.
6 ـ قسم الرسائل الجامعية: والعمل فيه جارٍ على إحصاء الرسائل الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، كما ويتمّ إعداد موضوعات حسينيّة تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.
7 ـ قسم الترجمة: والعمل فيه جارٍ على ترجمة التراث الحسيني باللغات الأُخرى إلى اللغة العربيّة.
8 ـ قسم الرصد: ويتمّ فيه رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في الفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية بمختلف المعلومات.
9 ـ قسم الندوات: ويتمّ من خلاله إقامة ندوات علميّة تخصّصية في النهضة الحسينية، يحضـرها الباحثون، والمحقّقون، وذوو الاختصاص.
10 ـ قسم المكتبة الحسينية التخصصية: حيث قامت المؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المطبوع.
11 ـ قسم الموقع الإلكتروني: وهو قسم مؤلّف من كادر علمي وفنّي؛ يقوم بنـشر وعرض النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسسة، كما ويتكفل بتغطية الجنبة الإعلامية للمؤسسة ومشاريعها العلمية.
12 ـ قسم المناهج الدراسية: ويحتوي على لجنة علمية فنية تقوم بعرض القضية الحسينية بشكل مناهج دراسية على ناشئة الجيل بالكيفية المتعارفة من إعداد دروس وأسئلة بطرق معاصرة ومناسبة لمختلف المستويات والأعمار؛ لئلا يبقى بعيداً عن الثورة وأهدافها.
13 ـ القسم النسوي: ويتضمن كادراً علمياً وفنياً يعمل على استقطاب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها للعمل ضمن أقسام المؤسسة؛ للنهوض بالواقع النسوي، وتغذيته بثقافة ومبادئ الثورة الحسينية.
14 ـ القسم الفني: ويتضمن كادراً فنيّاً متخصصاً يقوم بطباعة وإخراج وتصميم النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسسة، وكذلك الإعلانات والدعوات ومختلف الملصقات والأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها كافة الأقسام.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها قريباً إن شاء الله تعالى.
هذا الكتاب:
إنّ موضوع الحوادث الكونية والكرامات التي وقعت بعد حادثة عاشوراء له أهمية بالغة على عدة مستويات حيث إنّه يعكس رأي السماء وموقفها من تلك الواقعة الأليمة؛ لأنّه عندما تبكي وتمطر السماء دماً، أو عندما يخرج الدم من تحت الأحجار والأشجار، وعندما تحصل التغييرات في الكون من أجل ذبيح كربلاء، وعندما تتعدد تلك الحوادث وتتنوّع الكرامات ، فإنّ هذا يدل على أمور كثيرة، منها: حقانية النهضة الحسينية ومبادئها وقائدها وأهدافها ونتائجها، ومنها: أنّها تدل على بطلان من خالفها بشخصه ومنهجه ومبادئه، وكذا من أيدها أو رضي بها أو لم يخالفها، ومنها: بيان وإظهار عظمة الإمام الحسين× الذي تغير الكون لمظلوميته، ومنها: تجلي الغضب الإلهي، ومنها: ظهور وإتمام الحجة على من خالف نهج الحسين×.
إلى غير ذلك من الدلالات والمعاني والحقائق التي تدل عليها تلك الحوادث والكرامات، ولأهمية الموضوع وخطورته فقد حاول بعض السلفية ومن تأثر بهم أن يشكك في تلك الحوادث ساعياً إلى نفيها، خوفاً من النتائج العظيمة المترتبة عليها.
من هنا جاءت هذه الدراسة التوثيقية التحليلية من قبل الدكتور الشيخ حكمت الرحمة وهو أحد أعضاء مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية في قسم التأليف والتحقيق والحائز على درجة الدكتوراه في الحديث والتاريخ، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على تلك الحوادث من خلال البحث السندي على وفق قواعد ومعطيات ومباني علم الرجال عند الفريقين بدراسة موضوعية علمية محايدة بعيداً عن التعصب والتمييز، وقد تخللها بحوث تحليلية عديدة مهمة ومؤثرة، كما وقد أجاب عن مجموعة من الشبهات والإشكالات في المقام.
لذلك فإنّ هذا الكتاب يتميز بهذه الأمور المهمة من حيث كفاءة المؤلف وتخصصه، ومن حيث المنهج المتبع، ومن حيث حجم المادة المبحوثة في هذا الموضوع، ومن حيث النتائج المهمة التي توصل إليها.
وفي الختام نتمنّى للمؤلِّف والمترجم دوام السداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، إنّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلمية في
مؤسّسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
لم تكن واقعة عاشوراء وليدة ساعتها، فهي كغيرها من الأحداث ساهمت الكثير من الظروف في تكوّنها وحصولها.
كما أنّها كحدث لم تكن قد حصلت في اليوم العاشر فقط، بل نعتقد أنّها انطلقت في المدينة المنورة حين رفض الحسين× بيعة يزيد بن معاوية، فكانت (اللاء) الحسينية بوجه يزيد، هي انطلاقة لشرارة الثورة ضدّ الاستبداد والعبودية، وقد توّجت الثورة في يوم عاشوراء حين زُفّت قرابين الشهادة إلى العليّ الأعلى مُعلنةً انتصار الدم على السيف ، قُتل الحسين× وصعدت معه أرواح العشّاق إلى عنان السماء، وفاضت كربلاء بدمائهم الزكية؛ لتنطلق بعد ذلك حلقة أُخرى من حلقات هذه الثورة المباركة.
تمثّلت هذه الحلقة بمسيرة الإباء والشموخ لأُسارى آل محمد’، والتي أخذت على عاتقها إحياء الثورة، وتخليدها، وبيان حقائقها.
فكما أنّ تلك الثورة المباركة لم تكن قد بدأت في يوم عاشوراء، فكذلك أنّها لم تنتهِ في يوم عاشوراء، بل صار عاشوراء يوم انطلاق جديد لإحياء الثورة، وبيان معانيها، والتعريف بقائدها، والوقوف على أهدافها.
فانطلقت في تلك اللحظة القيم الحسينية لتخاطب الضمير الذي أُريد له أن يموت، وتخاطب الوجدان الذي غيّبه الخوف، فكانت الثورة في شقّها الثاني، والذي يمكن أنْ نسميه بالجانب الإعلامي للثورة.
تكفّل ركب السبايا وعلى رأسهم زين العابدين× وعمّته العقيلة زينب‘ بفضح البيت الأُموي، والوقوف بوجه إعلامه المضلِّل، فكانت لخطبهم وكلماتهم وقعاً في نفوس السامعين، وتأثيراً على وجدانهم وضمائرهم، كما أنّها كشفت الكثير من الحقائق عمّن غُيّبت عنه بفعل الإعلام المعادي.
هذا من جانب، ومن جانب آخر كان هناك تدخّلاً للسماء في بيان الحقيقة، هذا التدخّل كان أكثره على نحو إعجازي، أو لا أقل من كونه خارج النظم الطبيعية المتعارفة، باعتبار أنّ الأُمور الإعجازية والكرامات المشاهدة والمسموعة هي أكثر وقعاً في النفوس وتأثيراً على الوجدان، فنقل التاريخ أحداثاً عظيمة حصلت بعد عاشوراء كمطر السماء دماً، واحمرار السماء، وكسوف الشمس، وغيرها الكثير.
ولا نشكّ في أنّ هذه الأحداث تحمل في طياتها الكثير من الدلالات على حقانية الثورة، وعظمة قائدها، وغير ذلك ممّا سنُشير إليه أثناء البحث.
غير أنّ هذه الأحداث وإنْ كانت مقبولة عند الشيعة الإمامية في الجملة؛ باعتبار أنّ الحسين× يمثّل ثالث أئمّة أهل البيت المنصوبين من السماء، فلا غرابة عند قراءة ثورته، والوقوف على مغزاها، والطريقة في قتله، أنْ تحصل تلك الأحداث.
إلّا أنّها محلّ جدل عند الفريق الآخر وخصوصاً علماء السلفية، فبادروا إلى إنكار الكثير منها، بل ورميه بالكذب والاختلاق، وهذا ما يُعطي ضرورة وأهميّة للقيام بهذا البحث على نحو التفصيل.
فإنصافاً للحقيقة وبعيداً عن تراشق الاتهامات، وبُغية السير خلف الدليل، ارتأينا أن نسبر غور هذه الأحداث، لعلّنا نصل فيها إلى القول الحقّ بحسب ما تُمليه علينا الدراسة العلمية بعيداً عن التعصّبات المذهبية والميول العاطفية.
فكان الغرض من الكتاب هو توثيق تلك الأحداث من كُتب الفريقين، ثمّ ملاحظة الثابت من عدمه، مع إشارات من هنا وهناك إلى الدلالات والمعطيات التي يمكن الوقوف عليها من خلالها.
وحيث إنّ هذه الوقائع هي وقائع تاريخية، فإنّ المسلك في إثباتها هو تجميع القرائن من أجل الحصول على الوثوق بتحقّقها.
ومن القرائن التي نرى أنّها تُفيد الوثوق واستفدنا منها في كتابنا هذا هي:
أوّلاً: الصحة السندية الحاصلة من خلال البحث السندي، بمعنى أن يكون السند مقبولاً بما يشمل الحسن، والموثّق، والقوي، والجيد، وغيرها من أوصاف القبول التي تُفيد الوثوق بتحقق وحصول الحادثة.
ولا يُتوهم بأنّ المراد من البحث السندي هو الأخذ بما صحّ ورفض الضعيف وردّه، بل إنّ هناك عدّة معطيات نستفيدها من البحث السندي، وأهمّها:
1 ـ تحقيق أحد معايير الاعتماد التاريخي، وهو الوثوق بالصدور الناشئ من وثاقة الرواة وقبولهم، وهو ما أشرنا إليه فيما مضى.
2 ـ التحقّق من وجود أو عدم وجود كذّابين أو متّهمين بالكذب في سلسلة السند، إذ ثمّة فارق كبير بين الكذّاب وبين الضعيف أو المجهول، فبناء على تطبيق المنهج الحديثي حتّى في التاريخ، كما يذهب إليه بعضهم، فإنّ الأوّل وهو الكذّاب لا تنجبر معه الطرق عادةً، فمهما تعدّدت الطرق وكان في رواتها كذّابين، فإنّها لا ترقى إلى القبول أو لا أقلّ أنّ نسبة المعاضدة، واحتمال تقوية الخبر بالآخر هي ضعيفة جدّاً، بخلاف الثاني، أي: الضعيف أو المجهول، فهو قابل للانجبار، فقد ينجبر الخبر الضعيف بوروده من وجه آخر فقط، فضلاً عن التعدّد، فإنّه قد يوصل الخبر إلى درجة الصحة.
3 ـ إنّ نسبة حصول الاستفاضة الموجبة للاطمئنان، أو الوثوق بحصول الحادثة وصدق الخبر من خلال التعدّد، تكون ضعيفة جدّاً إنْ لم تكن معدومة في الأخبار المتضمّنة أسانيدها للكذّابين أو المتّهمين بالكذب، بخلاف الأخبار المتضمّنة أسانيدها للضعفاء أو المجاهيل، فإنّ نسبة تعاضدها وحصول الوثوق أو الاستفاضة المفيدة للاطمئنان تكون بنسبة قويّة.
4 ـ إنّ وجود الكذّابين والمتّهمين يُعدّ أحد القرائن القوية على كذب الخبر ووضعه، بخلاف الضعفاء والمجهولين، فإنّ وجودهم لا يساوق عدم صدور الخبر أو عدم تحقّق الحادثة، وكذلك لا يساوق الثبوت أيضاً، بل يبقى الخبر على الاحتمال، فقد يكون الخبر ثابتاً واقعاً، وقد يكون لا، ومعه لا يمكن وصف الخبر المروي عن الضعيف أو المجهول بأنّه خبر مكذوب أو موضوع.
بل لربّما يذهب جملة كبيرة من العلماء إلى الأخذ بالخبر الضعيف في القضايا التاريخية، قال النووي: «وقد قدّمنا في مواضع أن أهل العلم متفقون على العمل بالضعيف في غير الأحكام وأُصول العقائد»[1].
ثانياً: قد اتّضح من خلال ما تقدّم معياراً آخر لقبول الأخبار، وهو تعدّد الطرق وإنْ كانت ضعيفة من حيث السند، وهذا التعدّد له أنواع شتّى، فتارةً يُوجب صيرورة الخبر بحكم الحسن أو الصحيح، فيتحقّق معه المعيار الأوّل، وتارةً يُوجب الوثوق بصدور الخبر وتحقّق الحادثة، بمعنى أنّه يعطي نسبة ظن قوية تضاهي الصحة السندية إنْ لم تكن أقوى، وهذا يُعدّ قرينة معتبرة على قبول الخبر التاريخي، وتارةً يُوجب الاستفاضة الموجبة للاطمئنان بالصدور والتحقّق، وتارةً يصل إلى درجة التواتر، وهي حالات تكاد تكون نادرة.
وكيفما كان فإنّ أيّ تعدّد للطرق يحقّق الحالات المشار إليها يُعدّ قرينة قوية على الإثبات التاريخي.
ثالثاً: رواية الحادثة أو الخبر في كتب الفريقين خصوصاً مع تعدّد الراوي المباشر أو تعدّد الطرق، فإنّ هذا يوجب الوثوق بصدور الرواية، وإنْ كان وجودها منفرداً في روايات كلّ فريق لا يولّد وثوقاً كوجود طريق واحد ضعيف أو طريقين فقط، لكن في حال ورود الخبر في كُتب كلا الفريقين مع اختلاف الأهواء والميولات، وفي مسألة حساسة تقتضي عادةً عدم وجودها في كُتب الفريق الآخر، فإنّ ذلك بلا شك يولّد وثوقاً عقلائياً بأنّ الحدث والخبر صحيح؛ إذ لا مصلحة للفريق الآخر بالنقل غير الصحيح لأمر لا يتماشى مع عقيدته وهواه.
وبناء على ما تقدّم تجدر الإشارة إلى أنّ التصحيح السندي وفق قواعد وأصول أهل السنّة ليس من باب الأخذ بتوثيقاتهم والاعتماد عليها، بل لأنّه يشكل قرينة قوية على صحّة وتحقّق تلك الحادثة واقعاً.
فهذه المعايير الثلاثة هي التي اعتمدناها في دراستنا هذه، وفي غير ذلك، فإنّ الخبر إذا خلا من وجود الكذّاب والمتّهم فهو خبر ضعيف محتمل الصدور وعدمه، فلا نجزم بعدم صدوره ولا ندّعي تحقّقه، فيبقى في خانة الاحتمال، وقد يكون ثابتاً ومتحقّقاً في الواقع، ولعلّ المستقبل يكشف عن وجود طرق أُخرى له قد خُفيت علينا.
نعم، قد ترافق الخبر الضعيف قرينة تقوّي نسبة حصول الحادثة، وسنُشير لذلك في محلّه إنْ شاء الله.
وأمّا الخبر المنفرد الذي في سنده كذّاب أو متّهم، فطبيعي أنّ نسبة عدم صدوره أقوى بكثير من صدوره، فهو أقرب إلى الخبر الموضوع والمكذوب من غيره، نعم وفق احتمالية أنّ الكذّاب قد يصدق ربّما يرفض البعض نسبة الوضع والجزم به لمجرّد وجود الراوي الكذّاب فيه، إلّا أنّه من الواضح أنّ وجود الكذّاب يُعدّ قرينة قوية على كذب الخبر ووضعه.
هذا ما يتعلّق بالمعايير التي اعتمدناها في ثبوت الأخبار من عدمه.
وأمّا ما يتعلّق بالحوادث وطرق تخريجها وجمعها، فكان الاقتصار على الحوادث والكرامات التي جرت بعد عاشوراء، وكان لها تعلّق بتلك الحادثة دون ما سواها، فلا يشمل الكتاب الكرامات التي حصلت قبل عاشوراء، ولا ما لا تتعلّق بعاشوراء، وقد اعتمدنا في التخريج ـ عادةً ـ على المصادر الأساسية للرواية والخبر، وكان التركيز عليها وحاولنا جهد الإمكان ذكر الرواية بطرقها المتعدّدة إنْ وجدت، والإشارة لعدّة من المصادر الأساسية إنْ رواها أكثر من مصدر، ثمّ نردفها بعد ذلك ببعض المصادر الثانوية من دون استيعاب في ذلك، فما دام مصدر الخبر الأساسي موجوداً، والرواية منقولة عن نفس الراوي المباشر، لا نرى ضرورة لتحشيد المصادر الثانوية، وهي عديدة بطبيعة الحال.
ثمّ إنّه في حال عدم وجود المصدر الأساسي لضياعه، أو عدم وصوله، أو عدم عثورنا عليه، فسنضطر حينئذٍ لاعتماد المصدر الثانوي مع الإشارة إلى المصدر الأساسي الذي نقل منه الخبر والرواية.
وأمّا ما يتعلّق باستقصاء الحوادث واستيعابها، فلا شكّ في أنّنا ذكرنا أكثر وأهم الحوادث، وقد بذلنا جهوداً مُضنية في استيعابها، إلّا أنّنا لا ندّعي حصول ذلك، فقد تكون فاتت منّا حوادث من هنا وهناك، فهي كثيرة جدّاً ومتفرّقة في كُتب عديدة.
نعم، في الحوادث المتعلّقة بالأفراد والأشخاص، فحيث إنّها عديدة جدّاً، وعدم وجود خلاف كبير فيها، إذ إنّ الطرف الآخر يقرّ بحدوث أكثرها كما سيأتي؛ لذا فلم نقصد استيعابها وشمولها في كتابنا هذا، وإن كنّا قد ذكرنا أهمّها، بل أكثرها وتركنا منها متفرّقات من هنا وهناك؛ لعدم الضرورة لذكرها.
ومع هذا العمل من التخريج، وذكر الطرق المتعدّدة للخبر، والإشارة لعدّة من مصادره الثانوية بعد ذكر مصادره الأساسية، ودراسة الأخبار من جهة السند، ومعرفة ما ورد منها عند السنّة وما ورد منها عند الشيعة، نكون قد وفّرنا على الباحث والمحقق جهداً جهيداً، وقدّمنا له مادة متكاملة عن كلّ حادثة، وحينئذٍ فبغض النظر عن قبوله بالمعايير التي اعتمدناها في قبول الحادثة من عدمه، فإنّ توفير هذه المادة العلمية بالشكل المشار إليه تمكّنه بسهولة من الحصول على نتيجة نهائية في كلّ مورد والحكم عليه قبولاً أو رفضاً.
هذا، وقد وقع الكتاب في ستّة فصول: دار الأوّل منها على حادثة مطر السماء، وتضمّن الثاني حادثة ظهور الدم تحت الأحجار، وتكفّل الثالث بمسألة بكاء السموات والأرض على الحسين× في حين خُصّص الرابع منها لجمع ودراسة الحوادث الكونية المتفرّقة، وأمّا الخامس فقد تكفّل بدراسة الحوادث الفردية المتفرقّة، وأمّا السادس فقد اختص بأجوبة الشبهات الموجّهة لهذه الحوادث، ثمّ بيان أهمّ الدلالات والمعطيات العامّة المستفادة من تلك الظواهر والأحداث.
وفي الأخير لا يفوتني أنْ أشكر كلّ مَن ساهم في وصول هذا الجهد إلى ما هو عليه، وأخصّ بالذكر الأخ الأستاذ المحقّق عمّار الفهداوي، الذي تفضّل علينا مشكوراً ووضع تحت تصرّفنا جملة من الأحداث التي كان قد استخرجها بجهده الشخصي.
كما أقدّم وافر شكري وتقديري إلى مؤسسة وارث الأنبياء في الدراسات التخصصية في النهضة الحسينيّة، وجميع القائمين عليها لما وفّروه من خدمات جليلة على المستويين الإداري والعلمي من أجل إنجاح مهمّة هذا الكتاب.
فللجميع دعائي بكلّ خير وتوفيق.
هذا، وكلّنا أمل بالمحققين الكرام والأساتذة والخطباء والقرّاء الأعزاء، أن يجودوا علينا ويتحفوننا بما تؤول إليه أنظارهم من نقد، أو إشكال، أو ملاحظات تسهم في خدمة هذا الكتاب ورفع نواقصه.
نسأل الله سبحانه وتعالى أنْ يتقبّل منّا هذا اليسير، وأن يجعل الحسين× شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا مَن أتى الله بقلب سليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
حكمت الرحمة
المقالة I.
hekmat.alrahma@gmail.com
مبحث تمهيدي حول
معنى الكرامات وتحقّقها للأحياء والأموات عند أهل
السنّة
من الواضح للمتتبّع أن ليس ثمّة خلاف كبير في تحقّق أصل الكرامات للأولياء، وأنّ هذا الموضوع ليس من مختصّات الشيعة، بل عليه جمهور أهل السنّة بما فيهم الفرقة السلفية، يقول ابن تيمية: «كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنّة والجماعة، وقد دلّ عليها القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم...»[2].
وذكروا في عقائد الإمام أحمد بن حنبل، أنّه كان يذهب إلى جواز الكرامات للأولياء وينكر على مَن ردّها ويضلّله[3].
وقال الطحاوي متحدِّثاً عن الأولياء: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصحّ عن الثقات من رواياتهم»[4].
وقال السبكي: «وكرامات الأولياء حق»، وفسّرها المحلّى: أي جائزة وواقعة[5].
وقال ابن عابدين: «كرامات الأولياء ثابتة»[6].
وذكر النووي أنّ إثبات الكرامات هو مذهب أهل السنّة[7]، وعقد في كتابه (رياض الصالحين) باباً أسماه: باب كرامات الأولياء وفضلهم[8].
وقال القرطبي: «كرامات الأولياء ثابتة، على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة، والآيات المتواترة، ولا ينكرها إلّا المبتدع الجاحد، أو الفاسق الحائد»[9].
وعدّ الذهبي إنكار الإسفراييني لكرامات الأولياء بأنّها زلّة كبيرة[10].
كما أنّ المتتبّع لشراح الحديث سيجدهم يعلقون عقب الكثير من الأحاديث والحوادث الدالّة على كرامات معيّنة ما حاصله: وفيه إثبات كرامات الأولياء.
وممّا جاء في جواب محمد بن عبد الوهاب لأهل القصيم في بيان عقيدته إجمالاً: «وأقرّ بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات»[11].
وفي كتاب أُصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة: «الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أُصول الإيمان دلّت عليه نصوص الكتاب والسنّة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحّة ذلك وأنّه حق. وإلّا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه ردّ للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عمّا كان عليه أئمّة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب»[12].
وقد أفرد عدّة من علماء أهل السنّة مصنّفات في خصوص كرامات الأولياء، كأبي بكر الخلال وابن الأعرابي وابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهم.
هذا، وقد أنكر المعتزلة الكرامات، وأثبتها منهم أبو الحسين البصري[13]، وكذلك أنكرها من الأشاعرة الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو عبد الله الحليمي[14].
وقد تصدّى عدّة من العلماء للإجابة عن شبهات المنكرين لا نرى ضرورة لذكرها[15].
والخلاصة أنّ كرامات الأولياء ثابتة عند جمهور أهل السنّة.
بقي أنْ نعرف المراد من الأولياء ثمّ المراد من الكرامات.
أمّا المراد من الأولياء في الجملة فهم أهل الإيمان والتقوى والصلاح، قال تعالى: (إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ)[16] وقال أيضاً: (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)[17]، وورد عن النبي| في الحديث المتّفق عليه بين المسلمين أنّه قال ـ كما في لفظ البخاري ـ: «إنّ الله قال: مَن عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمْعَه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإنْ سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»[18].
وقد عرّفهم جلال الدين المحلي، بقوله: «وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات، المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات»[19].
وعرفهم ابن حجر العسقلاني، بقوله: «المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته»[20].
وعرّفهم المعاصر حسن السقاف بقوله: «والصحيح عندنا في تعريف الولي هو: المسلم المؤمن الذي تعلّم ما يجب عليه معرفته من التوحيد والفقه الضروري، المحافظ على أداء الفرائض ثمّ الزائد عليهما من النوافل، ولا يشترط الإتيان بالنوافل كلّها، وإنّما بقدر الاستطاعة، المتوجه بصدق القلب والإخلاص لله تعالى في أعماله، الذي تكره نفسه المعاصي وتحبّ الطاعات، الغائر على حرمات الله تعالى المهتم بأمر المسلمين، ولا يشترط في حقّه ظهور كرامة على يديه. هذا هو التعريف الصحيح الجامع المانع في تعريف الولي عندنا»[21].
وأمّا الكرامات فهي جمع كرامة، وقد عرّفوا الكرامة بأنّها: «أمر خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد ولي؛ تأييداً له، أو إعانة، أو تثبيتاً، أو نصراً للدين»[22].
وعرّفوها أيضاً بأنّها: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوّة ولا هو مقدّمة، يظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح، ملتزم لمتابعة نبي كُلِّف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم[23].
ويظهر ممّا تقدّم أنّ حقيقة الكرامة تتقوم بثلاثة أمور أساسيّة، وهي:
1 ـ أنْ تكون خارقة للعادة.
2 ـ أنْ لا تكون مقرونة بدعوى النبوّة.
3 ـ وكونها على يد ولي.
وأمّا أهدافها والأغراض التي تقوم من أجلها فقد تكون متعدّدة ومختلفة بحسب موارد صدورها، وإنْ كان أكثر أهدافها يدخل تحت عنوان نصرة الدين، فالكرامات التي تقوم لإثبات حق معين، أو بيان باطل ما، أو دفع شبهة من الأذهان، أو تأييداً لشخص ما، كلّها تدخل في الحقيقة في باب نصرة الدين.
ومن قيود التعريف أعلاه أخرجوا عدّة من الأمور، فبقولهم (خارق للعادة) خرج ما كان على وفق العادة من أعمال، وخرج بقولهم (غير مقرون بدعوى النبوّة)، معجزات الأنبياء، كما خرج بقولهم (ولا هو مقدمة لها) إرهاصات النبوّة وهي الخوارق التي تتقدّم النبوّة.
كما خرج بقولهم (على يد ولي أو على يد عبد ظاهر الصلاح) ما يحصل للمشعوذين والسحرة والكهان من سحر وشعبذة.
غير أنّ المهم فيما تقدّم هو التفريق بين الكرامة والمعجزة، فهل أنّه لا فرق في حقيقة الأمرين سوى التحدّي وادّعاء النبوّة، فالمعجزة ما صدرت على يد نبي في مقام التحدّي، بخلاف الكرامة إذ لا تحدي فيها، أم أنّ الكرامة لا بدّ أنْ تكون دون المعجزة؟
ذهب عدد كبير من العلماء إلى عدم الفرق بين المعجزة والكرامة سوى ما ذكرنا، قال ابن عابدين: «والحاصل أنه لا خلاف عندنا في ثبوت الكرامة، وإنّما الخلاف فيما كان من جنس المعجزات الكبار، والمعتمد الجواز مطلقاً إلّا فيما ثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيان بسورة»[24].
وقال النووي: «إنّ الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها ومنعه بعضهم وادّعى أنّها تختصّ بمثل إجابة دعاء ونحوه، وهذا غلط من قائله، وإنكار للحسّ، بل الصواب جرياناً بقلب الأعيان وإحضار الشيء من العدم ونحوه»[25].
وقد أوضح ذلك الفقيه ابن حجر وذكر عدّة من العلماء الذين أشاروا إلى المائز الرئيس بين المعجزة والكرامة، فقال: «الذي عليه معظم الأئمّة أنّه يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها، وإنّما يفترقان في أنّ المعجزة تقترن بدعوى النبوّة، أي باعتبار الجنس أو ما من شأنه وإلّا فأكثر معجزات الأنبياء لا سيما نبيّنا محمّد وقعت من غير ادّعاء نبوّة، والكرامة تقترن بدعوى الولاية أو تظهر على يد الولي من غير دعوى شيء وهو الأكثر فمن أولئك الأئمّة الإمام أبو بكر بن فورك وعبارته: المعجزات دلالات الصدق ثم إنْ ادّعى صاحبها النبوّة فالمعجزة تدلّ على صدقه في مقالته فإنْ أشار صاحبها إلى الولاية دلّت المعجزة على صدقه في مقالته فتسمّى كرامة ولا تسمى معجزة، وإن كانت من جنس المعجزات»، وذكر عدّة من العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك، وأوضح عباراتهم منهم: إمام الحرمين، وأبو حامد الغزالي، والفخر الرازي، والبيضاوي، وحافظ الدين النسفي، وأبو القاسم القشيري.
ثمّ ذكر كلاماً لليافعي يفيد ما تقدّم، فقال: «قال الإمام اليافعي بعد نحو ذلك عن هؤلاء الأئمّة وغيرهم: فهؤلاء اتّفقوا على أنّ الفارق بينهما هو تحدّي النبوّة فقط، ولم يشترط أحد منهم كون الكرامة دون المعجزة في جنسها وعظمها؛ فدلّ ذلك على جواز استوائهما فيما عدا التحدّي كما صرّح به إمام الحرمين، فيجوز اجتماعهما فيما عدا التحدّي من سائر الخوارق حتّى إحياء الموتى»[26].
ثمّ ذكر عدّة كرامات حصلت وتمّ فيها إحياء الموتى من الحيوانات[27].
وجاء في حاشية العطار: «والمعجزة المؤيد بها الرسل أمر خارق للعادة بأنْ يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار الماء من بين الأصابع مقرون بالتحدّي منهم مع عدم المعارضة من المرسل إليهم بأنْ لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق، والتحدّي الدعوى للرسالة، فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم، والخارق من غير تحدٍّ وهو كرامة الولي»[28].
وفي كلام آخر لابن عابدين في ردّه على المعتزلة[29] وتمييزه بين المعجزة والكرامة، قال: «إنّ المعجزة لا بدّ أن تكون ممّن يدّعي الرسالة تصديقاً لدعواه والولي لا بدّ من أن يكون تابعاً لنبي وتكون كرامته معجزة لنبيه لأنّه لا يكون ولياً ما لم يكن محقّاً في ديانته واتّباعه لنبيّه حتى لو ادّعى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولياً، بل يكون كافراً ولا تظهر له كرامة، فالحاصل أن الأمر الخارق للعادة بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر من قِبَله أو من قِبَل آحاد أُمّته وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى النبوّة»[30].
وفي كتاب أُصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة لنخبة من العلماء: «الفرق بين المعجزة والكرامة: أنّ المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوّة، بخلاف الكرامة فإنّ صاحبها لا يدّعي النبوّة وإنّما حصلت له الكرامة باتّباع النبيّ والاستقامة على شرعه، فالمعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة، وذهب بعض الأئمّة من العلماء: إلى أنّ كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء لأنّ الكرامات إنّما حصلت للولي باتّباع الرسول، فكلّ كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه»[31].
وقد ذكروا أدلّة متنوعة على حصول الكرامات منها ما دلّ على أصل جوازها ومنها ما دلّ على وقوعها وهو كثير جدّاً.
فما دلّ على جوازها ما ذكروه من الدليل العقلي وهو أنّ وجود الممكنات مستند إلى قدرته تعالى الشاملة لجميعها، فلا يمتنع شيء منها على قدرته، ولا شك أنّ الكرامة أمر ممكن، ولا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته[32].
وأضاف بعضهم: «ويدلّ على ذلك وقوع المعجزة، فيلزم من إنكار الكرامة إنكار المعجزة لأنّ كلاهما خارق للعادة، وإنّما امتازت المعجزة عن الكرامة بأنّ المعجزة مقرونة بادّعاء النبوّة وبرهان عليها»[33].
وذكر الفخر الرازي في أربعينه أنّ تشريف الله تعالى عبده بمعرفته ومحبّته أعظم وأعلى من إعطائه رغيفاً في المفازة أو سقيه شربة من الماء، وإذا لم يبعد الأوّل، كيف يبعد الثاني[34].
كما ذكر وجوهاً عقلية عديدة للجواز في تفسيره لا نرى ضرورة لذكرها[35].
وقال النووي: «اعلم أنّ مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء وأنّها واقعة موجودة مستمرّة في الأعصار ويدّل عليه دلائل العقول وصرائح النقول، أما دلائل العقل فهي أمر يمكن حدوثه ولا يؤدي وقوعه إلى رفع أصل من أُصول الدين فيجب وصف الله تعالى بالقدرة عليه وما كان مقدوراً كان جائز الوقوع»[36].
وأمّا ما دلّ على وقوعها فقد ذكروا كرامات وردت في القرآن الكريم وكرامات عديدة جرت للصحابة والتابعين وغيرهم، وهي كثيرة جدّاً، منها:
الأول: ما ورد في القرآن الكريم
وهي عديدة، منها:
1 ـ ذكروا أنّه من الكرامات الثابتة بالقرآن قصّة أصحاب الكهف، الذين عاشوا في قوم مشركين، وهم قد آمنوا بالله، وخافوا أنْ يغلبوا على أمرهم، فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله (عزّ وجلّ)، فيسّر الله لهم غاراً في جبل، وجه هذا الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشّمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها، إذا طلعت، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، وبقوا في هذا الكهف ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً، وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، في الصيف وفي الشتاء، لم يزعجهم الحر، ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملّوا من النوم، فهذه كرامة بلا شك، بقوا هكذا حتّى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية، فسلموا منه[37].
2 ـ ومن ذلك قصّة مريم‘، وما حصل لها من الحبل من غير ذكر، وحضور الرزق عندها من غير سبب ظاهر، وتساقط الرطب عليها من النخلة في غير أوان الرطب[38].
3 ـ ومن ذلك قصّة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثمّ بعثه؛ كرامة له، ليتبيّن له قدرة الله تعالى، ويزداد ثباتاً في إيمانه[39].
4 ـ ومن ذلك قصة آصف بن برخيا، فإنّ إحضاره لعرش بلقيس في لحظة من مسيرة شهر خارق للعادة حتماً[40].
وقد ذكر النووي عدّة من الآيات القرآنية الدالّة على وقوع الكرامات فليراجع[41].
الثاني: ما نقلوه على لسان النبيّ’ من وقوع كرامات
وهي عديدة، منها:
1 ـ تكليم الطفل لجريج العابد، وقد أشار إليه ابن حجر الهيتمي[42]، وذكره الفخر الرازي[43]، وهو الحديث المروي في الصحيحين، عن أبي هريرة عن النبيّ’ أنّه قال: «قال لم يتكلّم في المهد إلّا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلاً عابداً فاتّخذ صومعة فكان فيها فأتته أُمّه وهو يصلّي فقالت: يا جريج فقال: يا ربّ أُمّي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلمّا كان من الغد أتتْه وهو يصلّي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربّ أُمّي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فانصرفت، فلمّا كان من الغد أتتْه وهو يصلّي فقالت: يا جريج، فقال: أي ربّ أُمّي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فقالت: اللّهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته، وكانت امرأة بغى يُتمثّل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم! قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعياً كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلمّا ولدت قالت: هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم قالوا: زنيتَ بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي فجاؤوا به فقال: دعوني حتى أُصلّي فصلّى فلمّا انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، مَن أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فاقبلوا على جريج يقبّلونه ويتمسّحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا...»[44].
2 ـ انفراج الصخرة عن الثلاثة الذين في الغار بدعائهم، وقد أشار إليه الهيثمي أيضاً[45]، وذكره الفخر الرازي[46] وهو ما ورد عن عبد الله بن عمر، أنّه سمع النبيّ’ قال: «عن ابن عمر (رضي الله عنهما)، عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صرخة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللّهم إنّي كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعي ثمّ أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فأتي به أبوى فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، اللّهم إن كنت تعلم أنّى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فرجة نرى منها السماء قال: ففرج عنهم وقال الآخر اللّهم إن كنت تعلم أنّى كنت أحبّ امرأة من بنات عمى كأشدّ ما يحبّ الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها تعطيها مائة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها، فلمّا قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلّا بحقّه فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أنّى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين، وقال الآخر: اللّهم إن كنت تعلم أنّي استأجرت أجيراً بفرق من ذرّة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيها، ثمّ جاء فقال: يا عبد الله، أعطني حقّي فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها، فإنّها لك فقال أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما استهزئ بك، ولكنّها لك، اللّهم إن كنت تعلم أنّى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا. فكُشِف عنهم»[47].
3 ـ قصّة البقرة التي كلّمت صاحبها، وكذلك تكلّم الذئب، وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ’ أنّه قال: «بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إنّى لم أُخلق لهذا، ولكني إنّما خُلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله! تعجباً وفزعاً أبقرة تكلم، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): فإنّي أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) بينا راعٍ في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب، فقال له: مَن لها يوم السبع يوم ليس لها راعٍ غيري. فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): فإنى أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر»[48].
4 ـ ما ورد في تكلم السحابة وسماع صوتها، وهو ما ورد عن أبي هريرة عن النبي أنّه قال: «بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة اسقِ حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلّه فتتبّع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لِمَ تسألني عن اسمى؟ فقال: إنّي سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقِ حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فأنّى أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثاً وأرد فيها ثلثه»[49].
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي سيقت في المقام.
الثالث: ما وقع للصحابة والتابعين وغيرهم من الكرامات
وهنا ذكروا كرامات كثيرة، ونحن نورد نماذج ممّا ذكروه، فقد قال ابن تيمية: «وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدّاً، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقرائته وكانت الملائكة تسلِّم على عمران بن حصين.
وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة، فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها.
وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) في ليلة مظلمة، فأضاء لهما نور مثل طرف السوط، فلمّا افترقا، افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره.
وقصة الصديق في الصحيحين «لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته، وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك.
فنظر إليها أبو بكر وامرأته، فإذا هي أكثر مماكانت، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا».
وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة.
وعامر بن فهيرة قتل شهيدا، فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما كان قتل رفع، فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع.
وقال عروة: فيرون
الملائكة رفعته وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش،
فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة، سمعت حسا على رأسها، فرفعته فإذا دلو معلق، فشربت
منه حتى رويت، وما عطشت بقية عمرها... وسفينة مولى رسول الله (صلى الله عليه
وسلّم) أخبر الأسد بأنّه رسول رسول الله
(صلّى الله عليه وسلّم)، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده... والبراء بن مالك كان
إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتدّت على المسلمين في الجهاد
يقولون: يا براء! أقسم على ربّك، فيقول: يا ربّ! أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم،
فيهزم العدو، فلمّا كان يوم القادسية، قال: أقسمت عليك يا ربّ لما منحتنا أكتافهم
وجعلتني أوّل شهيد. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيداً.
وخالد بن الوليد حاصر حصناً منيعاً، فقالوا: لا نسلِّم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره.
وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلّا استُجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق.
وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشاً أمر عليهم رجلاً يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية، الجبل! يا سارية، الجبل الجبل! فقدم رسول الجيش فسأله، فقال يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله». وذكر كثيراً من الكرامات إلى أن قال: «وهذا باب واسع، وقد بُسِط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع» ثمّ قال: «وأمّا ما نعرفه نحن عياناً ونعرفه في هذا الزمان فكثير»[50].
كما أنّ من الكرمات التي ذكرها ابن تيمية هي إحياء الموتى، فقال: «وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللّهم لا تجعل لمخلوق عليّ مِنّة. ودعا الله (عزّ وجلّ) فأحيا له، فرسه، فلمّا وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنّه عارية، وأخذ سرجه فمات الفرس»[51].
وقال أيضاً: «ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه: هلم نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم: أمهلوني هنيهة، ثمّ توضأ فأحسن الوضوء وصلّى ركعتين، ودعا الله تعالى فأحيا له حماره، فحمل عليه متاعه»[52].
وقال في كتاب آخر حول هذا الموضوع ـ أعني إحياء الموتى ـ: «فإنّه لا ريب أنّ الله خصّ الأنبياء بخصائص لا توجد لغيرهم ولا ريب أنّ من آياتهم ما لا يقدر أن يأتي به غير الأنبياء، بل النبي الواحد له آيات لم يأتِ بها غيره من الأنبياء، كالعصا واليد لموسى وفرق البحر، فإنّ هذا لم يكن لغير موسى، وكانشقاق القمر، والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات التي لم تكن لغير محمد من الأنبياء، وكالناقة التي لصالح فإن تلك الآية لم يكن مثلها لغيره وهو خروج ناقة من الأرض بخلاف إحياء الموتى فإنّه اشترك فيه كثير من الأنبياء، بل ومن الصالحين»[53].
وقال أيضاً: «وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء كما قد وقع لطائفة من هذه الأُمّة ومن أتباع عيسى فإنّ هؤلاء يقولون: نحن إنّما أحيى الله الموتى على أيدينا لاتّباع محمد أو المسيح فبإيماننا بهم وتصديقنا لهم أحيى الله الموتى على أيدينا فكان إحياء الموتى مستلزماً لتصديقه عيسى ومحمداً»[54].
وعوداً على ما نقلوه من الكرامات العديدة فقد ذكر ابن حجر الهيتمي عدّة من الكرامات وختمها بما صحّ في صحيح مسلم: «رُبّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»، وتعقبه بقوله: «قيل: لو لم يكن إلّا هذا الحديث لكفى في الدلالة لهذا المبحث»[55].
وذكر السفاريني أنّ كرامات الأولياء ثابتة بالعيان والبرهان، فمن جملة ما ذُكر بعض الآيات القرآنية المشار إليها فيما سبق، ثمّ قال: «وثانياً: ما تواتر معناه وإنْ كانت تفاصيله آحاداً من كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإلى وقتنا هذا ممّا ذاع وشاع، وملأ الآفاق والأسماع، وضاقت عن إحصائه الدفاتر، وشهدت بوجوده الأكابر والأصاغر، ولا ينكره إلا معاند ومكابر، فلا جرم فهو الحقّ الصراح الرادع لأهل الإنكار والكفاح...»[56].
ثانياً: في شمولها للإحياء والأموات
اتّضح ممّا سبق أنّه لا شكّ ولا ريب في ثبوت الكرامات، وذكرنا أدلّة وأمثلة كثيرة على ذلك، إلّا أنّه وقع الخلاف في أنّ الكرامات هل مختصّة بحال الحياة أم شاملة لحال الموت أيضاً؟
وإذا ما نظرنا إلى الدليل العقلي الذي سيق لإثبات الكرامة لعرفنا أنّه شامل للأموات أيضاً لأنّه يتحدّث عن قدرة الله وتعلّقها بالممكنات، والكرامة أمر ممكن ولا يلزم من تحقّقها محال لذاته، وهذا الأمر غير مختص بالحيّ فكما يجري الله تعالى الكرامة من أجل الولي الحي كذلك يمكن أنْ يجريها من أجل الولي الميت.
قال العطار: «ومما ينبغي أنْ يعلم أنّه حيث كانت الكرامة من الله تعالى فلا فرق في وقوعها بين كون الولي حيّاً أو ميتاً خلافاً لمن منعها بعد الموت فإنّه لا وجه له والله ذو الفضل العظيم»[57].
وفي فتاوى اللجنة الدائمة في جوابهم عى السؤال الرابع من الفتوى رقم (9027) جاء ما نصّه: «الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حياً أو ميتاً إكراماً له فيدفع به عنه ضراً، أو يحقق له نفعاً أو ينصر به حقّاً، وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد كما أنّ النبيّ لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، بل كلّ ذلك إلى الله وحده...»[58].
وموضع الشاهد من كلامهم هو شمول الكرامة للحي والميت.
إلّا أنّ ما يؤسف له هو تحريفهم لهذه الفتوى لاحقاً لتبقى بنفس الرقم مع حذف كلمة الميت منها لتكون بالشكل التالي: الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد حي من عباده الصالحين؛ إكرامًا له فيدفع به... إلخ، وهو ما ثُبّت فعلاً في موقعهم الرسمي، ولذا لا ينتابك العجب عزيزي القارئ حين ترى الاضطراب في محتوى هذه الفتوى من موقع إلى آخر ومن كتاب مطبوع إلى آخر، فما تمّ أخذه قبل التحريف كان يشتمل على كلمة حيّاً وميّتاً، وما تمّ أخذه بعد التحريف فقد حذفت منه كلمة ميتاً بالشكل الذي نوهنا عليه، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.
هذا وقد تتبّعنا الموضوع بدقّة حتى حصلنا على فتاوى اللجنة قد نُشرت في موقع الآلوكة بصورة صوتية، قد تمّ تسجيلها بصوت أحمد عزت من قِبَل وزارة التربية والتعليم السعودية، الإدارة العامة للتربية الخاصّة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش) فتتبعنا المقاطع المسجلة وقد عثرنا على الفتوى في الشريط رقم 12 الوجه الأول في الدقيقة 19 وتسع ثواني، وهو منشور في الموقع برقم 23[59]، وقد قُرِئت الفتوى كما أثبتناها بلا تحريف، وهذا دليل قوي على حصول التحريف لاحقاً، وأنّ هذه القراءة كانت قبل التحريف كما هو حال الكتاب المطبوع الذي اعتمدنا عليه فقد كان قبل التحريف، وقد تمّ الاحتفاظ بنسخة صوتية احتياطاً لما يتم تحريفه لاحقا أيضاً.
وكيف ما كان، فيكفي في الرد على السلفية أنّ كبيرهم ابن تيمية يؤمن بالكرامات للأموات كما سيأتي لاحقاً إنْ شاء الله.
وفي كتاب بريقة محمودية: «ويجوز التوسّل إلى الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد موتهم لأنّ المعجزة والكرامة لا تنقطع بموتهم.
وعن الرملي أيضاً بعدم انقطاع الكرامة بالموت.
وعن إمام الحرمين: ولا ينكر الكرامة ولو بعد الموت إلّا رافضي[60].
وعن الأجهوري: الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرّد منه فيكون أقوى في التصرّف»[61].
فهؤلاء عدّة من العلماء صرّحوا بثبوت الكرامة للأموات.
وبات واضحاً حيث إنّ الكرامة في حقيقتها إكرام من الله للولي والعبد الصالح فلا فرق في وقوعها حينئذٍ بين حال حياته وبعد مماته.
وعلى هذا يحمل كلام الرملي الشافعي حيث قال: «بأنّ الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء، وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما الأنبياء فلأنّهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجّون كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. والشهداء أيضاً أحياء شوهدوا نهاراً جهاراً يقاتلون الكفار.
وأمّا الأولياء فهي كرامة لهم، فإنّ أهل الحقّ على أنّه يقع من الأولياء بقصد وبغير قصد أُمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم، والدليل على جوازها أنّها أُمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال، وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع، وعلى الوقوع قصة مريم ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به التنزيل وقصّة أبي بكر وأضيافه كما في الصحيح، وجريان النيل بكتاب عمر، ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند، حتى قال لأمير الجيش: يا سارية، الجبل! محذراً له من وراء الجبل لكمين العدو هناك، وسماع سارية كلامه وبينهما مسافة شهرين، وشرب خالد السم من غير تضرر به. وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها»[62].
فلا يرد عليه ما قاله بعضهم بأنّه قد استُشهد بوقوع كرامات للأحياء ونحن نتكلّم عن كرامات الأموات، فإنّ مراده إنّ الكرامة حيث إنّها أمر ممكن وأنّها جائزة الوقوع من الله، يجريها بسبب الولي، وقد وقعت لعدّة من الأحياء فلا مانع حينئذٍ من وقوعها للأموات.
ويمكن أنْ يُستدلّ لشمول الكرامات لحال الوفاة أيضاً بتقرير أنّ الموت ليس عبارة عن حالة عدمية، بل هو انتقال من دار إلى دار أُخرى لها أحكامها الخاصّة بها، وبعض هذه الأحكام مشابهة للحياة الدنيا، وهذا المعنى تقرره عدّة من الآيات والروايات، وبه صرّح جملة من العلماء، فقد جاء في تذكرة القرطبي عن شيخه أحمد بن عمرو، وكذا نقله عنه ابن القيم في كتابه الروح: «إنّ الموت ليس بعدم محض، وإنّما هو انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك: أنّ الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنّه قد صحّ عن النبيّ: أنّ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنّ النبي قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصاً بموسى، وقد أخبرنا بما يقتضي أنّ الله تبارك وتعالى يردّ عليه روحه حتّى يردّ السلام على كلّ من يُسلّم عليه، إلى غير ذلك ممّا يحصل من جملته القطع بأنّ موت الأنبياء إنّما هو راجع إلى أنْ غُيّبوا عنّا بحيث لا ندركهم، وإنْ كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة، فإنّهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا»[63].
فحياة الشهداء والأنبياء، بعد موتهم وخروجهم من الدنيا، ممّا لا خلاف فيه، فكما تشملهم الكرامة في الدنيا فلا مانع أنْ تشملهم بعد الحياة أيضاً ما دام الأمر يتعلّق بالانتقال من دار إلى دار ليس إلّا.
وكما دلّت الآيات والروايات على الحياة فإنّها دلّت كذلك على أنّهم يسمعون الكلام وبإمكانهم القيام بعدّة من الأفعال كالدعاء والصلاة والاستغفار، ويمكن أنْ نبرز عدّة أدلّة على ذلك:
الأوّل: الآيات القرآنية المباركة الواردة في الشهداء:
(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) [64].
فالآيات الكريمة، بعد ما أثبتت أنّ الشهداء أحياء، أثبتت لهم عدّة من الآثار: يُرزقون، ويفرحون بما آتاهم الله من فضله، وغيرها، وهذه آثار مشابهة لآثار الحياة الدنيا؛ وهي تدلّل على أنّ الحياة البرزخيّة هي حياة تشابه هذه الحياة، وأنّ الموت انتقال من دارٍ مشاهدةٍ إلى دارٍ غير مشاهدة.
الثاني: وهو الحديث الصحيح المروي عن أنس عن النبي’ أنّه قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون»[65].
وفي صحيح مسلم: عن أنس، عن النبي’ أنّه قال: «مررت على موسى ليلة أُسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلّي في قبره»[66].
فهذان الحديثان، وغيرهما ممّا في الباب، يثبتان أثراً آخر من آثار الحياة البرزخية وهو الصلاة، وهو أثر متوافق مع آثار الحياة الدنيويّة، وظاهر لفظ الصلاة يستلزم الحركة والفعل من قيام وقعود وركوع وسجود، ويشمل الدعاء والاستغفار ونحو ذلك.
الثالث: ما ورد عن أبي هريرة، عن رسول الله’ أنّه قال: «ما من أحد يُسلِّم عليّ إلّا ردّ الله عليّ روحي حتّى أردّ×»[67].
قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح»[68].
وهذه الرواية تثبت صريحاً أنّ النبي’ يردّ السلام على جميع مَن يُسلّم عليه، وردّ السلام أثر آخر من آثار الحياة، وفعل مشابه لأفعال الحياة الدنيا، ومَن يسمع السلام ويردّه يمكنه أن يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم.
الرابع: ما أخرجه الحربي عن أوس بن أوس عن النبي’ قال: «أكثروا علىّ من الصلاة يوم الجمعة، فإنّ صلاتكم معروضة عليّ. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إنّ الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»[69].
قال النووي: «حديث أوس بن أوس هذا صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة»[70]. وصحّحه الحاكم والذهبي[71] والألباني[72].
والرواية تثبت أنّ النبي’ يسمع الصلاة، وأنّ له شعوراً وإدراكاً في قبره، وإلّا فلا معنى لعرض الصلاة على مَن لا يدرك معناها ولا يشعر بها، وهذا الإدراك والشعور هو أثر آخر من آثار الحياة الدنيا، خصوصاً أنّ النبي’ علّل ذلك بأنّ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وكأنّه يريد القول بأنّه حيٌّ كما كان في الحياة الدنيا بروحه وبدنه.
الخامس: السلام على النبي’ في الصلاة، فقد اتّفق المسلمون بكافّة انتماءاتهم على السلام على النبي’ في كلّ تشهد أو في خصوص الأخير من الصلاة، بقولهم: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاته»، فالسلام هنا بصيغة خطاب موجه للنبيّ’، فلو كان النبيّ’ لا يسمع ولا يبلغه السلام؛ لكان ذلك لغواً لا يأمر الله به ولا يفعله العقلاء.
وإذا قال قائل إنّ هذا الكلام إنّما يجري في الأنبياء والشهداء ولا يجري في سائر الصالحين؟
نقول بإنّ نفس الكلام يجري في الأولياء والصالحين، بل إنّ الحياة شاملة لمطلق الموتى، فكما ذكر ابن القيّم سابقاً: أنّ الوفاة هي انتقال من دار إلى دار. وقد دلّت الأخبار على حياة جميع الناس في عالم البرزخ.
قال ابن كثير: «وقد ورد: أنّ أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا الصلت بن دينار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيراً استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهمّ ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عمّن سمع أنساً يقول: قال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم): إنّ أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيراً استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا: اللهمّ لا تمتهم حتّى تهديهم كما هديتنا»[73].
وأخرج الحاكم وصحّحه عن النعمان بن بشير، قال: «سمعت رسول الله| يقول: ألا أنّه لم يبق من الدنيا إلاّ مثل الذباب تمور في جوّها، فالله في إخوانكم من أهل القبور فانّ أعمالكم تعرض عليهم»[74].
فنلاحظ هنا أنّ الأعمال تعرض عليهم، وهم يستبشرون بالأعمال الصالحة، ويدعون للأحياء إنْ كانت أعمالهم غير صالحة.
ولهذا فإنّ الصحابي أبا الدرداء كان يقول عند سجوده: «اللّهم إنّي أعوذ بك أنْ يمقتني خالي عبد الله بن رواحة إذا لقيته»[75].
كما أخرج مسلم في صحيحه، عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): إنّ الميت إذا وضع في قبره، أنّه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا»[76].
فالأخبار والروايات في ذلك عديدة وهي تثبت الحياة للموتى ووجود ارتباط لهم في عالم الحياة الدنيا بسماعهم لأصواتهم ودعائهم لهم واستبشارهم أو حزنهم على أعمالهم.
ومن ذلك يمكن الخروج بعدّة نتائج منها:
1 ـ إنّ ما هو المراد في محلّ البحث متحقّق في حق الأموات أيضاً، وهو أنّ ثبوت الكرامة للولي غير مختصة في الحياة الدنيا، فالميّت ليس بمعدوم، بل هو حي في الحقيقة ويسمع الكلام ويدعو ويستغفر، وغاية ما هنالك أنّه انتقل من دار إلى دار.
2 ـ كما أنّ الطلب من الحي والاستغاثة والاستعانة به فيما يقدر عليه أمر جائز، فكذلك هي في خصوص الميت، بعد أنْ ثبت أنّه حي في تلك الدار وله القدرة على الدعاء والاستغفار، فإنّ الطلب منه راجع في حقيقته إمّا إلى دعاء الميت من الله أنْ يقضي حاجة هذا المستغيث وهو أمر مقدور كما قدّمنا، أو هو طلب المستغيث من الله أنْ يقضي حاجته إكراماً للنبيّ أو الولي، وهو ممكن وغير مشتمل على أيّ نوع من الشرك، خصوصاً أنّ المستغيث لا يقصد عبادة مَن يستغيث به، بل هو يقرّ بعبادته لله الواحد الأحد ويعتقد بأنّ تدبير الأمور أولاً وآخراً هي لله وحده دون سواه.
نماذج من الكرامات التي جرت للأموات عند أهل السنّة
وخير ما يمكن الاستدلال به على إمكان الكرامات للأموات هو وقوعها، وهنا يمكن القول بأنْ وقوع الكرامات للأموات هو أمر حاصل على مرّ الأزمان والعصور ولا مجال لإنكاره، ولذا أقر به ابن تيمية، وذكر نماذج من الكرامات وله في ذلك كلام كثير، سنأتي عليه لاحقاً.
ومن النماذج التي ذكروها من وقوع الكرامات للأموات:
1 ـ ما وقع في حقّ أويس القرني، وأنّه لمـّا مات وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة، فدفنوه فيه وكفّنوه، في تلك الأثواب، ذكره ابن تيمية[77].
2 ـ ما وقع في حقّ الأحنف بن قيس، وأنّه لـمّا مات، وقعت قلنسوة رجل في قبره، فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مدّ البصر، ذكره ابن تيمية أيضاً[78].
3 ـ ما حصل لعاصم بن ثابت، فبعد أنْ قتله الكفار، وعلمت قريش بذلك بعث ناس منهم إليه ليؤتوا بشيء منه يُعرف لأنّه كان قتل رجلاً عظيماً من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئاً، أخرجه البخاري[79].
وأورده ابن عبد البر بنحو آخر فيه تفصيل أكثر، ما نصّه: «وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده ليحرقوه، وكان قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر فبعث الله مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء فلما أعجزهم قالوا: إنّ الدبر[80] ستذهب إذا جاء الليل حتّى بعث الله (عزّ وجلّ) مطراً جاء بسيل فحمله فلم يوجد، وكان قتلَ كبيراً منهم فأرادوا رأسه فحال الله بينهم وبينه»[81].
ولابن تيمية كلام كثير في الكرامات التي تحصل للموتى، كما أشرنا لذلك، فممّا قال في ذلك: «وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقّي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمّن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمَن استهان بها، فجنس هذا حق ليس ممّا نحن فيه، وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك»[82].
فحصول الكرامات للأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين هو أمر واقع وحاصل وما إنكاره إلّا إنكار للواضحات المسلّمات ليس إلّا.
الحسين× أحد أولياء الله عند الفريقين
وإذا ما رجعنا لموضوع الكتاب فهو يتناول ما جرى من كرامات وخوارق للعادات بعد شهادة الإمام الحسين×، ولا يشكّ أحد من الفريقين في أنّ الحسين من الأولياء الخلّص ومن الشهداء، بل هو سيّد الشهداء كما ورد في الحديث الصحيح: «الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة»، والذي له طرق متكثرة، لذا قال السيوطي بتواتره[83] وقال الألباني: «وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب، بل هو متواتر»[84].
فحياة الحسين إذن في تلك الدار ممّا لا كلام فيها، ومنزلة الحسين وعظيم فضله ومقامه السامي صرّحت بها الآيات واستفاضت بها الروايات، فالحسين هو أحد المشمولين بآية التطهير، والحسين أحد المشمولين بآية المباهلة، والحسين مشمول بحديث الثقلين والحسين هو الذي قال فيه جدّه: «حسين منّي وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً»[85]، وهكذا فالروايات في فضله وعلو منزلته كثيرة جدّاً، ولعله الأوحد الذي بكى له نبيّ الإسلام حين ولادته، واستمرّ بالعزاء عليه في مواطن عدّة وهو يُذكِّر الأُمّة به وبمظلوميته وبما يجري عليه، ويأتيه المَلك مراراً ويخبره بما يجري عليه ويعطيه تربة من تراب كربلاء[86]، والنبيّ’ يبكي لذلك ويشتدّ حزنه لما سيقع من بعده، فلا غرو إذن ولا غرابة في أنْ تحصل كرامات للحسين تأكيداً لعظم مقامه ونصرة للحقّ وبياناً للحقيقة، خصوصاً أنّ فجيعة مقتله فاقت كلّ الفجائع، وطريقة مقتله تقرح العيون وتدمي القلوب، يقول المناوي: «وتفصيل قصّة قتله تمزق الأكباد وتذيب الأجساد فلعنة الله على مَن قتله أو رضي أو أمر، وبعداً له كما بعدت عاد»[87].
ويقول السيوطي: «وفي قتله قصة فيها طول لا يحتمل القلب ذكرها فإنا لله و إنا إليه راجعون»[88].
فشاء الله أنْ يخلّد تلك المعركة وأنْ تبقى علائمها واضحة بيِّنة على مرّ التاريخ فحدث ما حدث من كرامات وخوارق للعادات وهو ما سنتناوله مفصّلاً في هذا الكتاب.
الفصل الأول : حادثة مطر السماء دماً لقتل الحسين×
تخريج ودراسة الأخبار الدالّة على الحادثة من مصادر الشيعة
أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر
وبحسب ما تتبعنا ووقفنا عليه، أنّ الرواة الذين نقلوا الحادثة في مصادر الشيعة تسعة، وهم:
1 ـ الريّان بن شبيب، عن الإمام الرضا×، عن آبائه^.
2 ـ المفضّل بن عمر، عن الإمام الصادق×، عن آبائه^، عن الإمام الحسن×.
3 ـ السيّدة زينب÷.
4 ـ الزهري.
5 ـ محمد بن سلمة، عمّن حدّثه.
6 ـ ميثم التمّار.
7 ـ عمرو بن ثبيت، عن أبيه.
8 ـ عمّار بن أبي عمّار.
9 ـ رجل من أهل بيت المقدس.
ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سنديّاً
ورد هذا المعنى في عدّة من الأخبار وبطرق عديدة، وبعض هذه الأخبار معتبرة سنداً، وبعضها الآخر ضعيف تصلح كشاهد ومؤيد وقرينة لحصول الحادثة، ولكي تكون الدراسة واضحة ومنظّمة ارتأينا أن نُقسِّم الروايات بحسب الصحة والضعف على طائفتين: الأُولى: الروايات المعتبرة سنداً، والثانية: الروايات الضعيفة.
الطائفة الأُولى: الأخبار المعتبرة من الجهة السندية
الخبر الأوّل: خبر الريّان بن شبيب
أخرجه الصدوق، قال: «حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه&، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، قال: دخلت على الرضا× في أوّل يوم من المُحرّم، فقال لي: يابن شبيب أصائم أنت ...» إلى أنْ قال: «يا بن شبيب، لقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه× أنّه لمّا قُتل جدّي الحسين (صلوات الله عليه)، مطرت السماء دماً وتراباً أحمر»[89].
من الواضح عند الشيعة وثاقة علي بن إبراهيم القمّي صاحب التفسير، بل هو من الأجلّاء[90]، وكذلك وثاقة أبيه إبراهيم بن هاشم، بل ادّعى السيّد ابن طاووس الاتّفاق على وثاقته[91]، وكذلك وثاقة الريّان بن شبيب[92].
وإن كان ثمّة كلام فهو في شيخ الصدوق محمد بن علي ماجيلويه، والتحقيق يقتضي وثاقته أيضاً بقرائن عدّة:
1 ـ إنّ الشيخ الصدوق أكثر من الرواية عنه، فقد أحصى الشيخ لطف الله الصافي ما رواه الصدوق عن شيخه ماجيلويه فبلغت مائتين وسبعين روايةً في الخصال، والعلل، ومعاني الأخبار، وثواب الأعمال وعقاب الأعمال[93].
2 ـ إنّ الشيخ الصدوق وكما هو معلوم التزم في الفقيه بأنّه لا يروي إلّا الصحيح، وما يكون حجّة بينه وبين ربّه، وقد ذكر طرق كتابه في المشيخة، وبعد التتبع وجدنا أنّ اثنين وخمسين طريقاً من طرقه إلى الرواة الذين ابتدأ بهم في كتابه هي من طريق شيخه ماجيلويه، وهذا يكشف أنّه ثقة عنده، واعتمد عليه كثيراً في كتابه هذا.
إنْ قيل: إنّ الصحة لا تستلزم الوثاقة، فقد يكون اعتمد على قرائن معيّنة في صحّة الروايات، فلا يمكن التمسّك بتوثيق شيخه ماجيلويه حينئذٍ.
قلنا: إنّ من المعروف أيضاً أنّ الشيخ يعتمد على وثاقة الراوي أيضاً كما صرّح في بعض المواضع[94]، ونظراً لكثرة طرقه عن شيخه ماجيلويه، فمن المستبعد جدّاً أنّ جميع تلك الطرق اعتمد في صحّتها على القرائن، ولم يعتمد ولو في بعض منها على وثاقة الرواة، خصوصاً مع ترضيه المستمر على شيخه كما سيأتي.
3 ـ إنّ الشيخ الصدوق ترضّى عنه كثيراً[95]، وخصوصاً في مشيخته، ويكاد يكون ذلك في جميع الموارد، إلّا في موارد نادرة فقد ترحم عليه فيها، والترضي خصوصاً مع هذه الكثرة أمارة على الوثاقة عند جملة من العلماء.
4 ـ أنّه من شيوخ الإجازة[96]، وطبق مبنى عدّة كثيرة من العلماء أنّ شيوخ الإجازة ثقات.
5 ـ يمكن القول أيضاً أنّ الرجل من المعاريف، فرواياته كثيرة، خصوصاً أنّه في مشيخة الفقيه، وحيث لم يقدح فيه أحد، فرواياته معتبرة.
والخلاصة: إنّ هذه قرائن عدّة، يُتقوّى من خلالها حال الرجل، ويمكن على ضوئها الاعتماد على روايته.
وقد اعتمد على روايته وقال بصحّتها جملة من المتأخرين على رأسهم العلّامة الحلّي.
قال بحر العلوم في ترجمة ما جيلويه: «وحديثه في (المنتقى)[97]، و(الحبل المتين)[98]، معدود في الصحيح، وكذا في كتب الاستدلال. وحكم العلّامة (رضي الله عنه) في (الخلاصة) بصحّة طرق الصدوق المشتملة عليه، كطريقه إلى إسماعيل بن رباح، والحسين بن زيد، ومنصور بن حازم، وغيرهم.
قال في (المنهج)[99]: وتابعه مشايخنا على ذلك. وظاهره الاتّفاق على صحّة حديثه. وربّما ناقش فيه بعض المتأخّرين، وهو نادر.
وفي (الرواشح)[100]، و(ألقاب التلخيص)[101]: النصّ على توثيقه، وهو ظاهر (المنتقى)، و(مشرق الشمسين)[102]، وقد يُستفاد ذلك ـ أيضاً ـ من توثيق الشهيد الثاني في (الدراية) جميع المشائخ المشهورين من زمان الكليني إلى زمانه»[103].
تبيّن أنّ الحديث بهذا السند هو حديث معتبر صحيح، وعبّر عنه المجلسي الأوّل بالحسن كالصحيح[104].
الخبر الثاني: خبر المفضّل بن عمر
أخرجه الشيخ الصدوق في أماليه، قال: «حدّثنا أحمد بن هارون الفامي (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري، قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه^: أنّ الحسين بن علي بن أبي طالب× دخل يوماً إلى الحسن×، فلمّا نظر إليه بكى، فقال له: ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟! قال: أبكى لما يُصنع بك. فقال له الحسن×: إنّ الذي يؤتى إليّ سمٌّ يُدس إليّ فاُقتل به، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل، يدّعون أنّهم من أُمّة جدّنا محمد’، وينتحلون دين الإسلام، فيجتمعون على قتلك، وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك، فعندها تحلّ ببني أُميّة اللعنة، وتمطر السماء رماداً ودماً، ويبكي عليك كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات، والحيتان في البحار»[105].
أمّا أحمد بن هارون الفامي أو القاضي كما في بعض الأخبار[106]، والذي ورد أيضاً بعنوان أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي[107]، فهو من مشايخ الصدوق الذين أكثر عنهم الرواية مترضياً ومترحماً عليه في موارد كثيرة.
وهذا المقدار كافٍ في التعويل على الرجل واعتبار روايته كما نوّهنا إلى ذلك فيما تقدّم.
ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري، ثقة من وجوه الشيعة[108].
وأبوه كذلك لا إشكال في وثاقته[109].
وأمّا أحمد بن محمد بن يحيى، فالظاهر هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فإنّ الذي يروي عنه الحميري وهو يروي عن محمد بن سنان إنّما هو ابن عيسى، وقد روى عن ابن سنان كما ذكر السيّد الخوئي اثنين وتسعين مورداً[110]. وابن عيسى هذا هو الأشعري، وهو ثقة بلا كلام[111].
وأمّا ما ورد بعنوان (أحمد بن محمد بن يحيى) فلم نجد هكذا شخص يروي عن محمد بن سنان، ويروي عنه الحميري.
وأمّا محمد بن سنان، فهو إمامي وقع فيه كلام كثير، واختلفت الأقوال والأخبار في تضعيفه أو توثيقه، لكن كثيراً من المحقّقين انتهوا إلى وثاقة الرجل، بل كونه من خُلّص الشيعة، ومن خواصّ الأئمّة^[112].
وأمّا المفضّل بن عمر، فهو وإنْ اختلفت فيه الأقوال والروايات، إلّا أنّ الروايات المادحة له مستفيضة، ويُستفاد منها جلالة قدره، وأنّه من خواصّ أئمّة أهل البيت^، وقد وثّقه الشيخ المفيد، وعدّه الشيخ الطوسي من السفراء الممدوحين، وقد فصّل السيّد الخوئي الكلام فيه وانتهى إلى أنّه جليل ثقة[113].
تحصّل مما تقدّم، أنّ هذا السند صحيح معتبر يمكن التعويل عليه.
الخبر الثالث: خبر عمرو بن ثبيت عن أبيه
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني حكيم بن داوُد بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن عيسى، عن أسلم بن القاسم، قال: أخبرنا عمرو بن ثبيت، عن أبيه، عن علي بن الحسين÷، قال: إنّ السماء لم تبكِ منذُ وضُعت إلّا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي÷. قلت: أيّ شيء كان بكاؤها؟ قال: كانت إذا استُقبلت بثوب، وقع على الثوب شبه أثر البراغيث من الدم»[114].
أمّا حكيم بن داوُد، فهو من مشايخ ابن قولويه، وقد أكثر عنه، وترحّم عليه في بعض الأحيان، فهو ثقة.
وسلمة بن الخطاب، قال فيه النجاشي: «كان ضعيفاً في حديثه، له عدّة كتب»[115].
وقد نُوقش في هذه العبارة وأمثالها بعدم دلالتها على تضعيف نفس الراوي، فإنّها تُطلق على مَن يروي عن الضعفاء أو يروي المراسيل، وإنْ كان في نفسه ثقة، فلا يمكن الحكم بتضعيف الراوي على ضوئها.
وإذا ما عرفنا أنّ سلمة هذا من رجال كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، بل إنّ سلمة هذا من مشايخه، وبنينا على أنّ اعتماد ابن الوليد ومَن وافقه من المشايخ على وثاقة رواة النوادر سوى ما استثنوا، فسيكون سلمة ثقة؛ لأنّ ابن الوليد لم يذكره في جملة ما استثناه[116].
وإذا لم نقبل بهذا، فكذلك يمكن القول بتوثيق سلمة بناءً على رواية جملة من الأجلّاء عنه، منهم: ابن الوليد، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى العطار، وسعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الصفّار، وغيرهم[117].
وبالطريقين المتقدّمين حكم الوحيد البهبهاني بوثاقة الرجل وجلالته[118].
أمّا محمد بن أبي عمير، فهو من وجوه الطائفة وثقاتها الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون ولا يُرسلون إلّا ممّن يوثق به، وهو من أصحاب الإجماع أيضاً.
وهنا ينفتح لنا مجال الحكم بصحّة الرواية من دون دراسة بقيّة سندها؛ وذلك طبق المبنى القائل بأنّ هناك إجماع على تصحيح ما يصحّ عن جملة من المشايخ، والذي منهم ابن أبي عمير.
أمّا بناءً على عدم قبول هذه القاعدة، فلا بدّ من إتمام دراسة بقيّة السند، فنقول:
أمّا الحسين بن عيسى، فيمكن القول بوثاقته بناءً على وجوده في كامل الزيارات، إلّا أنّ هذا المبنى غير تام، وقد تراجع عنه السيد الخوئي في أواخر عمره.
ويمكن أيضاً القول بوثاقته بناءً على أنّ ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة، كما أشرنا، وهذه القاعدة وإن وقع فيها الخلاف، إلّا أنّها وقعت محلاً للقبول عند عدّة من العلماء والفقهاء كما لا يخفى.
وأمّا أسلم بن القاسم، فهو مجهول، ولم يذكروه.
وأمّا عمرو بن ثبيت (عمر بن وهب)، فمجهول ولم يذكروه أيضاً.
وأمّا أبوه (ثبيت)، فقد ذكره النجاشي، وقال: «إنّه كان ممّن يروي عن أبي عبد الله»[119].
تحصّل أنّ السند فيه عدّة من المجاهيل، فبناءً على تمامية قاعدة أصحاب الإجماع، وهم الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، بمعنى أنّ الرواية تكون صحيحة بمجرّد صحّة السند إلى أحدهم من دون حاجة إلى بحث بقيّة السند، فتكون الرواية صحيحة، وإلا فهي ضعيفة.
الطائفة الثانية: الأخبار التي لم يثبت اعتبارها، لكنّها تُؤيِّد وقوع الحادثة
أخرجه ابن قولويه، قال: «وعنه [يعني أبيه]، عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، قال: حدّثني أبو معشر، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين×، أمطرت السماء دماً»[120].
ابن قولويه وأبوه لا كلام في وثاقتهم، ونصر بن مزاحم أيضاً من الثقات، قال فيه النجاشي: «كوفي، مستقيم الطريقة، صالح الأمر، غير أنّه يروي عن الضعفاء، كُتبه حسان»[121]. وعدّ له مجموعة من الكُتب منها كتاب مقتل الحسين×[122]، ومن المحتمل جدّاً أن تكون هذه الرواية من كتابه هذا.
وذكره الشيخ في الرجال[123] والفهرست مجرّداً عن التوثيق والتضعيف، وعدّ له مجموعة من الكُتب ومنها كتاب مقتل الحسين×[124].
وذكره العلّامة في القسم الأوّل من خلاصته[125].
وقال ابن أبي الحديد: «هو ثقة ثبت، صحيح النقل»[126].
وترجمه الزنجاني وانتهى إلى أنّ أخباره في غاية الجودة، وأنّ خبره يُعدّ كالصحيح[127].
والكلام في ثلاثة، عمر بن سعد، وأبو معشر، والزهري.
أمّا عمر بن سعد، فهو ليس ابن أبي وقّاص قائد معسكر ابن زياد كما قد يُتوهم، فإنّ ذاك ليس بشيخ لنصر بن مزاحم؛ لأنّ وفاة نصر بن مزاحم كانت في سنة (212هـ)، ومقتل الحسين× كان في سنة (61هـ)، ووفاة عمر بن سعد وقتْله كان في سنة (66هـ)، فهما في عصرين وزمانين مختلفين.
وعمر بن سعد هذا، هو ابن أبي الصيد الأسدي كما ذكره تلميذه نصر بن مزاحم في وقعة صفّين[128]، وعمر هذا لم أقف له على ترجمة في كُتب الرجال الشيعية، فهو مُهمل، غير أنّه من رجال كامل الزيارات، فبناءً على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، يكون الرجل ثقة بلا معارضة، غير أنّ هذا المبنى محلّ جدل، والسيّد الخوئي بنفسه قد تخلّى عنه في آخر حياته.
لكن النظر في روايات الرجل توقفك على أنّه من الشيعة الإمامية، ويهتم بنقل فضائل أهل البيت^ وما جرى عليهم؛ ولذا فإنّ أهل السنّة حين وقفوا على عقيدته وكونه من خلّص الشيعة، ضعّفوه ولم يعتدّوا بروايته، فهذا ابن أبي حاتم وهو من كبار رجال الجرح والتعديل يقول فيه: «عمر بن سعد الأسدي... سألت أبى عنه. فقال: شيخ قديم من عُتّق الشيعة، متروك الحديث»[129]. وقال الذهبي: «شيعي بغيض، قال أبو حاتم: متروك الحديث»[130].
وذكر النمازي أنّ له كتاباً جمع فيه جملة من كتب أمير المؤمنين× وغيرها[131]. وقد روى عنه نصر بن مزاحم كثيراً.
فيمكن الركون إلى روايته والقول بحسن حاله، وقد ترجمه الشيخ الزنجاني وانتهى إلى نتيجة أنّه: «شيخ من بني أسد، لا أحسبه إلّا إماميّاً صحيح العقيدة»[132].
لكن في بعض الأخبار كما في الكافي[133]، وكامل الزيارات[134]، وغيرها[135] ورد أنّ نصر بن مزاحم يُحدّث عن عمرو بن سعيد وليس عن عمر بن سعد، وهناك نُسخ اختلفت في نفس الرواية، فبعضها ذكرت عمر بن سعد، وبعضها ذكرت عمرو بن سعيد، فتتولّد هنا احتمالات أُخرى، فإمّا أنْ يكون هناك تصحيف، وأنّ شيخ نصر هو أحدهما، فيكون إمّا عمر بن سعد (المهمل)، أو عمرو بن سعيد (المعروف على ما سيأتي).
أو أنّ لنصر شيخين متشابهين في الاسم، أحدهما عمر بن سعد، والآخر عمرو بن سعيد
والظاهر من معجم الرجال للسيّد الخوئي أنّهما اثنان؛ لأنّ السيّد ذكر عمر بن سعد بعنوان مستقل، وصرّح بأنّ نصر بن مزاحم يروي عنه[136].
وذكر عمرو بن سعيد بعنوان مستقل، وصرّح بأنّ نصر بن مزاحم يروي عنه[137]، وفي ترجمة نصر بن مزاحم ذكر أيضاً أنّه يروي عن عمرو بن سعيد مستنداً في ذلك على رواية في الكافي فيها نصر بن مزاحم، عن عمرو بن سعيد[138].
فالنتيجة طبق تجميع هذه المعطيات أنّ السيّد الخوئي يرى أنّ لنصر شيخين، أو أنّ السيّد لم يلتفت إلى التشابه بين الاسمين في شيوخ نصر فلم يتكفّل بحث ذلك.
ثمّ إنّ السيّد يرى أنّ عمرو بن سعيد الوارد في روايات عديدة جدّاً، هو عمرو بن سعيد المدائني؛ حيث قال: «هذا متحدٌ مع عمرو بن سعيد المدائني»[139]. وعمرو بن سعيد المدائني ثقة روى عن الرضا× كما ذكر النجاشي[140].
وفي كامل الزيارات بتحقيق القيومي، رجّح المحقّق أنّ شيخ نصر هو عمرو بن سعيد المدائني، وليس عمر بن سعد، وذكر ذلك في عدّة موارد من دون تحقيق يُذكر، سوى أنّه يدّعي أنّ شيخ نصر هو عمرو بن سعيد المدائني[141].
والتحقيق يقتضي أنّ هناك تصحيف في الاسم، وأنّ شيخ نصر هو عمر بن سعد، وليس عمرو بن سعيد؛ وذلك لعدّة قرائن:
الأُولى: في بعض نُسخ الكافي أنّ الذي روى عنه نصر هو عمر بن سعد وليس عمرو بن سعيد، كما أشار إلى ذلك المحقّق الأردبيلي[142]، وهذا يدلّ على التصحيف وعدم التعدّد.
الثانية: إنّ المواضع التي وردت في كامل الزيارات وفيها أنّ نصر بن مزاحم روى عن عمرو بن سعيد، قد جاءت في نُسخة أُخرى أنّ الذي روى عنه نصر هو عمر بن سعد مكان عمرو بن سعيد، ممّا يدلّ أيضاً على التصحيف وعدم التعدّد.
الثالثة: إنّ نصر بن مزاحم روى في وقعة صفّين أكثر من ثمانين خبراً كلّها عن عمر بن سعد، ولم يرد ذكر لعمرو بن سعيد ولا في خبر واحد. وكذلك في بقيّة الكتب، فإنّ أكثر رواياته عن عمر بن سعد، وليس عمرو بن سعيد.
الرابعة: إنّ عمر بن سعد ورد في كتب أهل السنّة بهذا العنوان، ووصفوه بأنّه من عُتّق الشيعة، وشيعي بغيض، وهذا يناسب أنْ يكون شيخ نصر هو عمر لا عمرو.
ومن مجموع هذه القرائن يتحصّل أنّ شيخ نصر هو عمر بن سعد، وليس عمرو بن سعيد.
ويؤيّد ذلك أيضاً أنّ وفاة نصر في سنة (212هـ)، فالمناسب من شيخه أنْ يروي عن الإمام الكاظم×، في حين نرى أنّ عمرو بن سعيد المدائني يروي عن الإمام الرضا×، ويروي كثيراً عن مصدق بن صدقة الذي يروي بدوره عن الإمام الكاظم×، في حين لم نجد لعمرو بن سعيد رواية واحدة عن الإمام الكاظم×، وهذا يؤكّد أنّ عمرو المدائني هو غير عمر بن سعد، وأنّ شيخ نصر هو عمر بن سعد لا المدائني.
وبعد مدةً من الزمن وأثناء بلوغي أواخر الكتاب، وقع بيدي كتاب الرجال للشيخ الزنجاني، في نسخته الـ(pdf) المعدّة للطباعة، حيث إنّ الكتاب لم يُطبع بعدُ، فاستذكرت إشكالية عمر بن سعد هذه، وراجعت النُّسخة المذكورة للكتاب في ترجمة نصر بن مزاحم، فوجدته يقول: «وروى في موضعين أو مواضع عن عمرو بن سعد أو سعيد، وهو مصحّف عمر بن سعد جزماً، كما هو المتحقّق»[143].
أمّا أبو معشر، فهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، ذكره الطوسي في أصحاب الإمام الصادق×[144]، وذكر النجاشي بأنّ له كتاب الحرّة[145].
ترجمه السيّد الخوئي مقتصراً على ذكر الطوسي والنجاشي له[146].
وترجمه التستري وأضاف إلى ذلك أنّ الرجل مترجم في كُتب أهل السنّة، وذكر ترجمة الخطيب له، واستظهر بعدها أنّ الرجل من العامّة وليس من الشيعة، فقال: «وحيث لم يُنسب إليه تشيُّعاً، ولم ينقله عن أحد فالظاهر عامّيته، وعنوان رجال الشيخ أعمّ، وأمّا النجاشي فمثل الشيخ في الفهرست قد يعنون العامّي إذا كان ذا كتاب مفيد لنا. ويؤيّده أنّه اقتصر فيه على روايته كتابه الحرّة، والحرّة وقعة يزيد بالمدينة وإن كان ظاهر سكوته عن مذهبه إماميّته.
وقد سكت ابن النديم أيضاً عن مذهبه، وهو ظاهر في عامّيته، فقال: أبو معشر، واسمه نجيح المدني، مولى، وكان مكاتباً لامرأة من بني مخزوم وعُتِق، عارف بالأحداث والسير، وأحد المحدّثين، توفّي أيام الهادي، وله من الكُتب كتاب المغازي، وعنونه ابن حجر والذهبي وسكتا عن مذهبه، لكنّهما قالا: الهاشمي مولاهم»[147].
أقول: قد تتبّعنا تراجمه في كتب السنّة، ولم نقف على ما ينفعنا في المقام سوى أنّه كان مولى لبني هاشم، وحكم أكثرهم بضعف حديث الرجل، ولا يمكن من خلال ذلك البناء على تشيُّعه، وأنّ تضعيفهم له ناشئ من ذلك.
فالخلاصة: إنّ أبا معشر مجهول، إلّا على مبنى وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، فيكون ثقة.
نعم، للشيخ الزنجاني رأي آخر، فهو يرى أنّ أبا معشر هذا ليس نجيح، بل هو شخص غيره، قال: «وأمّا أبو معشر الذي روى عنه نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عنه، عن الزهري في (باب 28 من كامل الزيارة)، وإن كان عصره واحداً[148] إلّا أنّ الظاهر كونه يوسف بن يزيد البراء البصري أبو معشر، من رواة العامّة، وحديثه غاية في الجودة»[149].
وأمّا الزهري، فهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من رجال العامّة، بل من أئمّتهم وثقته عندهم وجلالة قدره ممّا لا خلاف فيها.
وأمّا عند الشيعة فقد ذكره الشيخ الطوسي وقال عنه: «عدو»[150].
وقال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في التحرير الطاوسي عند ذكره لسفيان بن سعيد، والزهري: «والمشار إليهما عدوان مُتّهمان، وقد ذكرت في بعض ما ألفت شيئاً يتعلّق بحالهما»[151].
لكن السيّد الخوئي والتستري يرون أنّه محبّ لزين العابدين×، فقد ذكر السيّد الخوئي رواية تتضمّن تأثر الزهري بكلام الإمام زين العابدين×، وقوله: «الله يعلم حيث يجعل رسالته»[152]، ثمّ ملازمته له، وقال بعد ذلك: «الزهري وإنْ كان من علماء العامّة، إلّا أنّه يظهر من هذه الرواية وغيرها، أنّه كان يحب علي بن الحسين× ويعظمه»[153].
وذكر بعد ذلك عدّة من الروايات، وقال بعدها: «وبما ذكرنا يظهر أنّ نسبة العدواة إليه على ما ذكره الشيخ لم تثبت، بل الظاهر عدم صحتها»[154].
وقال التستري: «ثمّ لو كان الشيخ قال فيه: (عامّي) كان صحيحاً، وأمّا قوله: (عدوّ) فليس بحسن، وكيف! والأخبار بمحبته للسجّاد× متواترة»[155].
أمّا المازندراني فيرى خلاف ذلك فيقول: «وأمّا نصبه وعداوته فممّا لا ريب فيه، وقد ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري، وقبله العلّامة في قسم الضعفاء»[156].
والخلاصة: نحنُ أمام رأيين متناقضين في الرجل، لكنّ هذا التناقض غير مُضر بالرواية التي نحن في صددها، والتي تتكلّم عن مطر السماء دماً؛ وذلك لأنّه إنْ كان عدوّاً ومبغضاً لأهل البيت^، فهذه الرواية تعدُّ بمنزلة الإقرار؛ إذ لا معنى لأنْ يكذب الإنسان في شيء على خلاف مصلحته، خصوصاً إنّه كان من أتباع بني أُميّة.
وإن كان الرجل غير مبغض، بل هو محبٌ للإمام زين العابدين×، وله عدّة روايات يرويها عنه في الكافي، والفقيه، والتهذيب، والاستبصار، فهذا يدلّ على حسن حال الرجل وإمكان الاعتماد عليه.
هذا وقد انتهى الزنجاني إلى أنّ الرجل أحاديثه جيّدة[157].
تبيّن أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة أبي معشر فقط، وهو يُعدّ قرينة تتقوّى بها الأخبار المتقدّمة، وأمّا على القول بإنّ أبا معشر هو يوسف بن يزيد (أبو معشر البراء)، وأنّ حديثه غاية في الجودة، فيمكن القول باعتبار هذا السند.
2 ـ خبر محمد بن سلمة عمّن حدّثه
أخرجه ابن قولويه، قال: «وعنه [يعني محمد بن جعفر الرزاز الكوفي]، عن محمد بن الحسين، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن سلمة، عمّن حدّثه، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي÷ أمطرت السماء تراباً أحمر»[158].
أمّا محمد بن جعفر الرزاز، فهو شيخ ابن قولويه، وشيخ الكليني، وقد أكثر عنه، ومن مشايخ الشيعة، فلا إشكال في وثاقتة[159]، وكذا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، فإنّه من الأجلّاء الثقات[160]، وقد تقدّمت وثاقة نصر بن مزاحم، وحسن حال عمر بن سعد، وأوضحنا أنّ شيخ نصر ليس عمرو وأنّ هذا تصحيف، وبقي عندنا في هذا السند محمد بن سلمة، وهو مشترك بين جماعة، بل ربّما يكون غيرهم، ولم يتسنَ لنا معرفته؛ لأنّ شيخه هنا مجهول والراوي عنه عمر بن سعد أيضاً لم يذكروه، فيصعب حينئذٍ التمييز بواسطة الشيوخ والتلاميذ.
تبيّن أنّ هذا السند ضعيف باثنين؛ محمد بن سلمة وشيخه، فإنّهما مجهولان.
أخرجه الشيخ الصدوق، قال: «حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس&، قال: حدّثنا أبي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن أرطأة بن حبيب، عن فضيل الرسان، عن جبلة المكية، قالت: سمعت ميثماً التمار (قدس الله روحه) يقول: والله لتقتلن هذه الأُمّة ابن نبيِّها في الـمُحرّم لعشر يمضين منه، وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة، وأنّ ذلك لكائن، قد سبق في علم الله (تعالى ذكره)، أعلم ذلك بعهد عهده إليّ مولاي أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، ولقد أخبرني أنّه يبكي عليه كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات، والحيتان في البحار، والطير في جو السماء، وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم، والسماء والأرض، ومؤمنو الإنس والجن، وجميع ملائكة السماوات، ورضوان ومالك وحملة العرش، وتمطر السماء دماً ورماداً. ثمّ قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين×، كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وكما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس.
قالت جبلة: فقلت له: يا ميثم، وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يُقتل فيه الحسين بن علي÷ يوم بركة؟! فبكى ميثم (رضي الله عنه)، ثمّ قال: سيزعمون بحديث يضعونه، أنّه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم×، وإنّما تاب الله على آدم× في ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي قَبِل الله فيه توبة داوُد×، وإنّما قَبِل الله توبته في ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس× من بطن الحوت، وإنّما أخرجه الله تعالى من بطن الحوت في ذي القعدة، ويزعمون أنّه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح× على الجودي، وإنّما استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل، وإنّما كان ذلك في ربيع الأوّل.
ثمّ قال ميثم: يا جبلة، اعلمي أنّ الحسين بن علي÷ سيّد الشهداء يوم القيامة، ولأصحابه على سائر الشهداء درجة. يا جبلة، إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنّها دم عبيط، فاعلمي أنّ سيّدك الحسين قد قُتل.
قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت الشمس على الحيطان كأنّها الملاحف المعصفرة[161]، فصحت حينئذٍ وبكيت، وقلت: قد والله، قُتل سيّدنا الحسين بن علي×»[162].
أمّا الحسين بن أحمد بن إدريس، فهو من مشايخ الصدوق، وقد أكثر عنه مُترحماً ومترضيّاً عليه، وهو من مشايخ الإجازة أيضاً، وهذه قرائن تدلّ على الوثاقة عند جملة من العلماء[163].
وقد يُحتمل أنّه هو الحسين الأشعري[164] الذي نصّ العلّامة على توثيقه[165]، لكن الوحيد في تعليقته استبعد كونه ابن أحمد[166]، وكذلك الخوئي، واستظهر أنّ الثاني هو ابن عمران[167].
أقول: ذكر ابن حجر في لسان الميزان ترجمة للحسين بن أحمد بن إدريس، جاء فيها: «الحسين بن أحمد بن إدريس القمّي، أبو عبد الله، ذكره الطوسي في مصنّفي الشيعة الإمامية، وقال: كان ثقة، روى عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، والتلعكبري، وغيرهم»[168].
لكن في الفهرست الموجود حالياً لا توجد هذه الترجمة، فلعلّه توجد نُسخة عند ابن حجر غير النُّسخة الواصلة إلينا والله العالم.
وأمّا أحمد بن إدريس فهو ثقة أيضاً[169].
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب تقدّم أنّه ثقة، وكذا نصر بن مزاحم، وعمر بن سعد حسن الحال كما تقدّم.
فتبقّى عندنا أرطأة بن حبيب، وفضيل الرسان، وجبلة المكية، وميثم التمار.
أمّا أرطأة بن حبيب، فهو كوفي ثقة[170].
وأمّا فضيل الرسان، فالظاهر كونه زيدي المذهب، ولم نقف على مَن نصّ على توثيقه، إلّا بناءً على وثاقة رجال تفسير القمي، وكذا كامل الزيارات، وكلاهما محلّ كلام كما لا يخفى.
وللسيّد الجلالي بحث لطيف حول حياة الرجل، انتهى فيه إلى اعتبار روايته، فقال: «والذي أراه أنّ الرجل معتبر الحديث، لمِا يبدو من مجموع أخباره وأحواله من انقطاعه إلى أهل البيت^، واختصاصه بهم، ونصرته لهم، وتعاطفه معهم، وكونه مأموناً على أسرارهم، وكذلك وقوعه في طريق كثير من الروايات ـ وكلّها خالية ممّا يوجب القدح فيه ـ فهذا كلّه مدعاة إلى الاطمئنان به، ولو التزمنا بكفاية عدم القدح في الراوي لاعتبار حديثه من دون حاجة إلى معرفة وثاقته بالخصوص ـ كما هو مذهب القدماء ـ لكان الرجل معتمد الحديث بلا ريب»[171].
وأمّا جبلة المكية، فهي مجهولة، ولم أقف على ذكر لها في غير هذا الخبر.
وميثم التمار من خُلّص أتباع أمير المؤمنين×.
تبيّن ممّا تقدّم اعتبار جميع رجال السند سوى جبلة المكية، فلم نقف على ترجمتها؛ فهو ضعيف لجهالتها.
أخرجه الشيخ المفيد في أماليه، وعنه الطوسي في الأمالي، قال: أخبرني أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: حدّثني أحمد بن محمد الجوهري، قال: حدّثنا محمد بن مهران، قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن عمر بن عبد الواحد، عن إسماعيل بن راشد، عن حذلم بن ستير، قال: «قدِمتُ الكوفة في الُمحرّم سنة إحدى وستين منصرف علي بن الحسين÷ بالنسوة من كربلاء، ومعهم الأجناد محيطون بهم، وقد خرج الناس للنظر إليهم، فلمّا أُقبل بهم على الجمال بغير وطاء، جعل نساء أهل الكوفة يبكين وينتدبن، فسمعت علي بن الحسين÷، وهو يقول بصوت ضئيل وقد نهكته العلّة، وفي عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى عنقه: أَلا إنّ هؤلاء النسوة يبكين، فمن قتلنا؟! قال: ورأيت زينب بنت علي÷ ولم أرَ خفرة قطُّ أنطق منها، كأنّها تُفرغ عن لسان أمير المؤمنين×. قال: وقد أومأت إلى الناس أنْ اسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكتت الأصوات... أفعجبتم أنْ قطرت السماء دماً؟! ولعذاب الآخرة أخزى»[172].
وفي الاحتجاج للطبرسي: «أفعجبتم أنْ تمطر السماء دماً»[173].
وأورده المشغري مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، قال: قال أبو إسحاق السبيعي، عن حذيم الأسدي، وأورده بلفظ: «أفعجبتم أن مطرت السماء دماً»[174].
وأورده السيّد ابن طاووس مرسلاً عن بشير بن خزيم الأسدي[175].
أمّا محمد بن عمران المرزباني، فقد ذكره ابن شهر آشوب، وقال: «له كتاب ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب»[176].
وهو من شيوخ السيّد المرتضى، وقد أكثر عنه في أماليه، وكذلك من شيوخ المفيد، وروى عنه عدّة من الروايات.
وذكره الحرّ العاملي، ونقل فيه قول ابن خلكان بأنّه «صاحب التصانيف المشهورة والمجاميع الغريبة، كان راوية للآداب، صاحب أخبار، وتآليفه كثيرة، وكان ثقة في الحديث ومائلاً إلى التشيع»[177]، وأضاف العاملي قائلاً: «والسيّد المرتضى روى عنه كثيراً في الدرر والغرر»[178].
وله تراجم في كتب أهل السنّة، فقد ذكره الخطيب، وقال: «كان صاحب أخبار ورواية للآداب، وصنّف كُتباً كثيرة في أخبار الشعراء المتقدّمين والمحدّثين على طبقاتهم، وكُتبا في الغزل والنوادر، وغير ذلك، وكان حسن الترتيب لمِا يجمعه، غير أنّ أكثر كُتبه لم تكن سماعاً له، وكان يرويها إجازةً، ويقول في الإجازة: أخبرنا، ولا يبيّنها»[179].
وقال: «وحدّثني ابن أيوب، قال: دخلت يوماً على أبي علي الفارسي النحوي، فقال: من أين أقبلت؟ قلت: من عند أبي عبيد الله المرزباني. فقال: أبو عبيد الله من محاسن الدنيا»[180].
وقال: «قال لي علي بن أيوب: وكان عضد الدولة يجتاز على بابه، فيقف ببابه حتى يخرج إليه أبو عبيد الله فيسلّم عليه ويسأله عن حاله»[181].
وبعد أنْ نقل بعض ما يتعلّق بأخباره، وذكر قول الأزهري بأنّه كان معتزلياً صنّف كُتاباً في أخبار المعتزلة، وما كان ثقة، خلص إلى نتيجة جاء فيها: «ليس حال أبي عبيد الله عندنا الكذب، وأكثر ما عِيب به المذهب، وروايته عن إجازات الشيوخ له من غير تبيين الإجازة، فالله أعلم»[182].
ثمّ ذكر قول العتيقي فيه: «وكان مذهبه التشيع والاعتزال، وكان ثقة في الحديث»[183].
وقال ابن النديم: «أصله من خراسان آخر مَن رأينا من الأخباريين المصنّفين، راوية، صادق اللهجة، واسع المعرفة، كثير السماع»[184].
فتبيّن من جميع ذلك أنّ الرجل معروف عند الفريقين، ورى عنه ـ عند الشيعة ـ المفيد والمرتضى، وهما من أجلّاء الطائفة، ولم يتعرّض أحد من علماء الشيعة لقدحه، وتُرجم له عند أهل السنّة، وقدحوه بالمذهب، فرموه بالتشيّع تارةً، وبالاعتزال أُخرى؛ لذا ضعّفه بعضهم، ووثّقه بعضهم، وانصبّ قَدحُ مَن قدحه على المذهب أوّلاً، وعلى روايته بالإجازة من دون تبيين ذلك ثانياً، فظاهر الرجل من جمع هذه القرائن أنّه صادق اللهجة غير متعمّد الكذب؛ فالنتيجة أنّه يمكن التعويل على روايته.
أمّا أحمد بن محمد الجوهري، فهو ضعيف الحديث واختلط في آخر عمره[185]، وكان النجاشي يروي عنه، وكان صديقه وصديق والده، لكن تجنّب الرواية عنه لاحقاً لتضعيفه من قِبل شيوخ الطائفة، قال: «رأيت هذا الشيخ، وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيتُ شيوخنا يُضعّفونه فلم أروِ عنه وتجنبته»[186].
ومحمد بن مهران، لم يذكروه، ولم أقف له على ترجمة.
وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، لم يذكروه، ولم أقف له على ترجمة، أو ذكْر في غير هذه الرواية محلّ البحث.
وعمر بن عبد الواحد، لم يذكروه، ولم أقف له على ترجمة، أو ذكْر غير هذه الرواية محلّ البحث.
وإسماعيل بن راشد، كسابقيه لم يذكروه، ولم أقف له على ترجمة.
أمّا حذلم بن ستير، فقد وقع الاختلاف في اسمه، فقد ورد في الاحتجاج باسم (حذيم بن شريك الأسدي)[187]، وبهذا الاسم ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام زين العابدين× من دون جرح ولا تعديل[188]، ووردت له أسماء أُخرى، نكتفي هنا بما ذكره الشيخ علي أكبر غفاري، قال معلّقا على حذلم بن ستير في خبر الأمالي للمفيد: «وفي بعض نُسخ الحديث حذلم بن بشير، وفي الاحتجاج حذيم بن شريك الأسدي، وعنونه في الجامع من أصحاب الإمام الحسين×، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام علي بن الحسين÷، وفي البحار في قصّة نزول أهل البيت^ قرب المدينة: (بشير بن حذلم)، وفي بلاغات النساء لابن طيفور مرّة حذام الأسدي، وأُخرى حذيم، وفي اللهوف بشير بن خزيم الأسدي، وقال في هامش البحار: والصحيح حذيم بن بشير»[189].
والخلاصة: إنّ الرجل لم يوثّق أيضاً.
اتّضح من خلال ما تقدّم أنّ هذا السند ضعيف.
أخرجه الشيخ الطوسي، قال: «أخبرنا ابن خشيش، قال: أخبرنا الحسين بن الحسن، قال: حدّثنا محمد بن دليل، قال: حدّثنا علي بن سهل، قال: حدّثنا مؤمل، عن حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّار، قال: أمطرت السماء يوم قُتل الحسين× دماً عبيطاً»[190].
أمّا ابن خشيش، فهو محمد بن علي بن خشيش التميمي، روى عنه الشيخ كثيراً في أماليه، كما أنّه من شيوخ النجاشي، فهو ثقة، لأنّ شيوخ النجاشي كلّهم ثقات.
ويبدو أنّه من رجال العامّة، فهو شيخ البيهقي، وقد روى عنه كثيراً[191].
وقال غلام رضا عرفانيان: «وهو من مشايخه [يعني مشايخ الطوسي] العامّة على ما في الإجازة الكبيرة للعلّامة، المذكورة في إجازات البحار»[192].
أمّا الحسين بن الحسن، فهو أبو زيد الحسين بن الحسن بن عامر، فلم نجد له ترجمة لا في كُتب الشيعة ولا في كُتب السنّة، وإنْ كان له ذكر في بعض روايات الفريقين، فيبقى حاله على الجهالة.
وأمّا محمد بن دليل، فهو أبو بكر محمد بن دليل بن بشر بن سابق الإسكندراني، فلم يُترجم له في كُتب الشيعة، وله ذكر في كتب السنّة، فقد ذكره الخطيب، وقال: «كان ثقة»[193]. وذكره السمعاني، وقال: «كان ثقة»[194].
وعلي بن سهل، ليست له ترجمة أيضاً.
ومؤمل، مجهول كذلك.
وأمّا حمّاد بن سلمة، فلم يُترجم له في كتب الشيعة، لكنّه من رجال تفسير القمي، فيكون ثقةً بناءً على وثاقة كلّ رجاله.
وله ترجمة مفصّلة في كُتب أهل السنّة، وهو ثقة من كبار أهل الحديث عندهم.
وعمّار بن أبي عمّار، ليس له ترجمة في كتب الشيعة، وله ترجمة عند أهل السنّة، وكان مولى لبني هاشم، وهو من التابعين يروي عن عدّة من الصحابة، وثّقه عدّة من علمائهم[195].
لعلّ هذا السند برمّته من أبناء العامّة، ابتداءً من ابن خشيش شيخ الطوسي وانتهاءً بعمّار بن أبي عمّار، وهذا يعطي للرواية وإن كانت ضعيفة قيمة أكبر، باعتبار عدم وجود الدواعي لروايتها، بل إنّ الدواعي على خلاف ذلك، ومع ذلك رويت.
وعلى كلّ حال فالسند ضعيف بعدّة من المجاهيل.
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي الناقد[196]، قال: حدّثني عبد الرحمان الأسلمي، وقال لي أبو الحسين، وأخبرني عمّي، عن أبيه، عن أبي نصر، عن رجل من أهل بيت المقدس أنّه قال: والله لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونواحيها عشيّة قَتل الحسين بن علي÷. قلت: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعنا حجراً ولا مدراً ولا صخراً إلّا ورأينا تحتها دماً عبيطاً يغلي، واحمرّت الحيطان كالعلق، ومطرنا ثلاثة أيام دماً عبيطاً، وسمعنا مناديا ينادي في جوف الليل يقول:
|
أتـرجـو أُمّـةٌ قـتلت
حـسينا |
|
شـفاعة جدّه يوم
الحساب |
|
مـعاذ الله لا
نُـلـتـم يـقـيـناً |
|
شفاعة أحـمد وأبـي
تراب |
|
قتلتم خير مَن ركب
المطايا |
|
وخير الشيب طراً
والشباب |
وانكسفت الشمس ثلاثة أيام، ثمّ تجلّت عنها وانشبكت النجوم، فلمّا كان من غد ارجفنا بقتله، فلم يأتِ علينا كثير شيء حتى نُعي إلينا الحسين×»[197].
أمّا محمد بن عبد الله الناقد، فهو وإن لم يُذكر إلّا أنّه ثقة بناءً على كونه من شيوخ ابن قولويه المباشرين.
وأمّا عبد الرحمن الأسلمي، فلم نقف له على ترجمة في كُتب الشيعة، ولم نتعرّف عليه من كُتب السنّة أيضاً؛ إذ إنّ عبد الرحمن الأسلمي الوارد في كتب أهل السنّة أكثر من شخص، وجلّهم بين تابعي أو صحابي.
فمثلاً عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، توفي (145هـ).
عبد الرحمن بن سنة الأسلمي، له رؤية.
عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي، يروى عن أبي هريرة[198].
عبد الرحمن بن ربيعة بن كعب الأسلمي، صحابي[199].
فالغرض أنّ عبد الرحمن هذا مجهول، وكذلك بقيّة رجال السند لم أقف على تراجم لهم.
تبيّن أنّ رجال هذا السند كلّهم من المجاهيل الذين لم يُترجم لهم سوى شيخ ابن قولويه، فهو ثقة بناءً على التوثيق العام الصادر من ابن قولويه، فلا يمكن تصحيح هذه الرواية إلّا بناءً على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، وقد تقدّم تراجع السيّد الخوئي عنه.
تخريج ودراسة الأخبار الدالة على الحادثة من مصادر أهل السنّة
أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر
1 ـ سليم القاص.
2 ـ نضرة الأزدية.
3 ـ خليفة بن صاعد.
4 ـ أُمّ سالم.
5 ـ السيِّدة زينب÷.
6 ـ إبراهيم النخعي.
7 ـ هلال بن ذكوان.
8 ـ قرط بن عبد الله.
9 ـ أُمّ سلمة.
10ـ ابن عباس.
11 ـ أحد الرهبان.
ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سندياً وفق مباني أهل السنّة
ورد هذا المعنى في عدّة من الأخبار وبطرق عديدة، وبعض هذه الأخبار معتبر سنداً، وبعضها الآخر ضعيف تصلح كشاهد ومؤيد لحصول الحادثة، ولكي تكون الدراسة واضحة ومنظمة ارتأينا أن نقسم الروايات بحسب الصحّة والضعف على طائفتين: الأُولى: الروايات المعتبرة سنديّاً، والثانية: الروايات الضعيفة.
الطائفة الأُولى: الأخبار المعتبرة سنديّاً
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا سليمان بن حرب، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدّثنا حمّاد بن سلمة، قال: حدّثنا سليم القاص، قال: مُطرنا دم[200] يوم قُتل الحسين»[201].
وأخرجه البلاذري، قال: «حدّثني عمر بن شبّة، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن سالم القاص، قال: مُطرنا أيام قتل الحسين دماً»[202].
وأخرجه الثعلبي من طريق أبي خيثمة: «حدّثنا حمّاد بن سلمة، أخبرنا سليم القاضي[203]، قال: مطرنا دماً أيّام قتل الحسين»[204].
وأورده البخاري في تاريخه، والرازي في الجرح والتعديل، وابن حبّان في ثقاته، كلّهم في ترجمة سليم القاص[205].
وأيضاً أورده السيوطي نقلاً عن ابن سعد[206].
عرفنا أنّ الخبر أخرجه ابن سعد، عن سليمان بن حرب، وموسى بن إسماعيل، عن حمّاد، عن سليم القاص، فنقول:
1 ـ سليمان بن حرب: من رجال الستّة، وثّقه عدّة من كبار العلماء، كالنسائي، وابن خراش، وابن سعد، وغيرهم[207]، وقال فيه ابن حجر: «ثقة إمام حافظ»[208]. وقال فيه الذهبي: «الإمام الثقة الحافظ، شيخ الإسلام»[209].
2 ـ موسى بن إسماعيل: قد عرفنا وثاقة سليمان بن حرب، إلّا أنّه لم ينفرد بالرواية، فقد تابعه عليها موسى بن إسماعيل، وهو من الثقات المعروفين أيضاً، قال ابن حجر: «ثقة ثبت»[210]. وقال الذهبي: «الحافظ الثقة، أبو سلمة موسى بن إسماعيل»[211].
3 ـ حمّاد بن سلمة: من رجال مسلم والأربعة، وروى له البخاري تعليقاً، وثّقه عدّة من أئمّة هذا الشأن: كأحمد بن حنبل، وابن معين، والساجي، والعجلي، وقد تكلّم فيه البعض لأوهام حصلت له، أو لتغيّر طرأ عليه في آخر عمره[212]؛ لذا قال فيه ابن حجر: «ثقة عابد، أثبت الناس فى ثابت، وتغيّر حفظه بآخره»[213].
لكن هذا التغيّر وتلك الأوهام لا تنقص من مكانة الرجل ووثاقته، فهو من أئمّة الحديث وأجلّة الثقات، فمع فرض صحّة ما تكلّموا فيه من التغيّر والأوهام، فإنّه لا يحطّ من حديث الرجل، ولا أقل من اعتبار حديثه حسناً، كيف لا، وقد قال فيه علي بن المديني: «مَن تكلّم في حمّاد، فاتّهموه في الدين»[214]، وقال أحمد بن حنبل: «إذا رأيت الرجل ينال من حمّاد بن سلمة، فاتّهمه على الإسلام»[215]، وقال ابن معين: «إذا رأيت مَن يقع فيه [يعني ابن سلمة] فاتّهمه على الإسلام»[216]؛ ولذا قال فيه الذهبي: «كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجّة إنْ شاء الله»[217].
وذكر الألباني أنّ الرجل متّفق على جلالته وصدقه[218]. وفي موضع آخر قال: «وحمّاد ثقة حافظ»[219] وذكر في تعليقه على السنّة أنّ في حمّاد كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن[220].
4 ـ سليم القاص، ذكره البخاري[221]، وابن أبي حاتم[222]، من دون جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «يُخطئ»[223]، فحديثه حسن؛ لأنّ الخطأ أمر طبيعي ملازم للبشر، ولا ينزل حديث الرجل عن رتبة الاحتجاج ما لم تكثر أخطاؤه، والمعروف عند أهل العلم أنّ الراوي إذا كان يُخطئ، فروايته قد تنزل من الصحّة إلى درجة الحسن، وهكذا يتعامل ابن حجر والألباني مع كثير من الرواة؛ قال الألباني: «فكثير من أئمّة الحديث وحفّاظهم ورواتهم الذين يقال إنّهم في الثقة كالجبال، مع ذلك لا ينجو منهم أحد من خطأ ومن وهم؛ ولذلك فالمعيار عند علماء الحديث في تصنيف المقبولين من الرواة والمردودين، هو أنّ مَن غلب عليه سوء الحفظ، فهو ضعيف، ومَن كان أحسن من ذلك، فهو الصدوق، والذي يُحتجّ بحديثه في مرتبة الحديث الحسن»[224].
وقال أيضاً في بيان قول ابن حجر في الراوي (صدوق يُخطئ): «إنّ قوله فيه: صدوق يُخطئ، ليس نصّاً في تضعيفه للراوي به، فإنّنا نعرف بالممارسة والتّتبع أنّه كثيراً ما يُحسّن حديث مَن قال فيه مثل هذه الكلمة»[225].
ولذا فإنّ ابن حبّان مع تصريحه بأنّه يُخطئ أورده في الثقات، ولم يورده في كتابه المجروحين.
وقد يقال: إنّ ابن حبّان يوثّق المجهولين اعتماداً على أصالة العدالة، فذكره للرجل في كتابه الثقات مع عدم التنصيص على وثاقته لا يدلّ على الوثاقة، فقد يكون الرجل مجهولاً.
1 ـ إنّ ابن حبّان يُعدّ من كبار علماء الحديث والجرح والتعديل عند أهل السنّة، وله رأي ونظر في الرواة، وطرق توثيقهم وتجريحهم، ومجرد اختلافه مع غيره في الاجتهاد لا يُقلل من قيمة رأيه، فيبقى ما ذكر من الرجال في كتابه الثقات عند ابن حبّان هم رواة ثقات يمكن التمسّك بهم؛ إذ لا نبحث في التصحيح والتضعيف عن إجماع عند الشيعة فضلاً عن أهل السنّة، فإنّ لكلّ فرقة مباني مختلفة ونظرات متغايرة، والإجماع من الندرة بمكان؛ لذا يُكتفى بوثاقة الراوي وفق مبنى معيّن وإن رفُض عند آخر؛ لرفضه ذلك المبنى، خصوصاً أنّ هذا المبنى له أنصار ومؤيدون ولم ينفرد به ابن حبّان.
2 ـ إنّ ابن حبّان لم يذكره في الثقات بناءً على أصالة العدالة؛ لأنّه ذكر أنّه يُخطئ، فهو يعرفه إذن، وإلّا من أين عرف أنّه يُخطئ، فهو لا بدّ أن يكون قد سبر له عدّة من المرويات وقارنها بغيرها، فتبيّن له أنّه يُخطئ، لكنّ خطأه لم يتجاوز الحد، فأورده في الثقات ولم يورده في المجروحين.
ثمّ إنّ هناك طرق أُخرى يمكن من خلالها التمسك بوثاقة واعتبار حال سليم القاص، وهي:
1 ـ إنّ الرجل سيكون مجهول الحال، والمُعبّر عنه بالمستور؛ لرواية أكثر من واحد عنه، مع عدم ورود جرح فيه[226]، فقد روى عنه حمّاد بن سلمة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عليّة[227]، وهناك طائفة من أهل العلم يرون حجية رواية مجهول الحال (المستور)، قال النووي: «والأصحّ قبول رواية المستور»[228]، بل نَسب الاحتجاج بروايته إلى كثير من المحققين[229]، وذكر ابن الصلاح أنّ الاحتجاج به هو قول بعض الشافعيين وبه قطع، منهم: الإمام سليم بن أيوب الرازي، ثمّ قال: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كُتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة، الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم»[230].
وممّن اختار قبول روايته، ابن جماعة، وكذا الطيبي، وقالا: «والمختار قبوله، وقطع به سليم الرازي»[231].
وقال الزركشي حول المستورين: «فذهب أكثر أهل الحديث إلى قبول رواياتهم والاحتجاج بها، منهم: البزار، والدارقطني»[232].
2 ـ إنّ الرجل ذكره البخاري وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه، ولم يجرحه أحد، وهناك مبنى يرى أنّ سكوت هؤلاء بمنزلة التوثيق للراوي، وقد ذهب إليه الشيخ التهانوي[233] والعلّامة أحمد شاكر[234]، وكذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة، ودافع عنه كثيراً، وذكر أنّ عدّة من العلماء يقولون به، منهم: المجد ابن تيمية، وابن حجر، وابن عبد الهادي، والمنذري، وغيرهم[235].
تحصّل أنّ الخبر بهذا الطريق هو صحيح أوحسن لذاته، ولو تنزلنا عن كلّ ما تقدّم من المباني فلا أقلّ من كون الخبر يتقوّى بوروده من طريق آخر، وهناك طرق أُخرى كثيرة سنذكرها فيما يأتي.
الخبر الثاني: خبر نضرة الأزدية
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثتنا أُمّ شوق العبدية، قالت: حدّثتني نضرة الأزدية، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مطرت السّماء دماً، فأصبحت خيامنا وكلّ شيء منّا مليء دم»[236].
وأخرجه ابن حبّان من طريق ابن قتيبة، قال: «ثنا العباس بن إسماعيل مولى بنى هاشم، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثتنا أُمّ شوق العبدية، قالت: حدّثني نضرة الأزدية، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مطرت السماء دماً، فأصبح جرارنا وكلّ شيء لنا ملأى دماً»[237].
وأخرجه البيهقي من طريق أبي الحسين بن الفضل القطّان: «أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدّثنا يعقوب بن سفيان: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثتنا أُمّ شوق العبدية، قالت: حدّثتني نضرة الأزدية، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مطرت السماء دماً، فأصبحت وكلّ شيء ملآن دماً»[238].
وأخرجه الحلبي من طريق البيهقي[239]، وأخرجه الخوارزمي في مقتله[240]، وأخرجه ابن عساكر من طريق البيهقي، والخطيب، وابن الطبري، كلّهم عن أبي الحسين بن الفضل القطّان، وساق الخبر بسند البيهقي المتقدّم[241].
وأورده السيوطي وعزاه إلى البيهقي، وأبي نعيم[242].
وأورده الذهبي من طريق الفسوي[243].
فهذا الطريق إذن، يدور على مسلم بن إبراهيم ومن بعده، وأمّا السند إلى مسلم فهو متعدّد، وصحيح بلا إشكال؛ ولذا فقد أورده المزي جازماً بصدوره من مسلم بن إيراهيم، قال: «وقال مسلم بن إبراهيم: حدّثتنا أُمّ شوق العبدية، قالت: حدّثتني نضرة الأزدية، قالت: لمّا أنْ قُتل الحسين بن علي مطرت السماء دماً، فأصبحت وكلّ شيء لنا ملآن دماً»[244].
وحيث إنّ ابن سعد سمع الحديث من مسلم بن إبراهيم مباشرةً؛ لذا سنقتصر على دراسة السند من مسلم بن إبراهيم ومن بعده.
1 ـ مسلم بن إبراهيم، هو الأزدي الفراهيدي البصري، من رجال الستّة.
قال أبو حاتم: «ثقة صدوق»[245]. وقال ابن معين: «ثقة مأمون»[246].
وقال ابن حبّان: «كان من المتقنين»[247].
وقال العجلي: «ثقة»[248].
وقال الذهبي: «الإمام الحافظ الثقة، مسند البصرة»[249].
وقال ابن حجر: «ثقة مأمون»[250].
2 ـ أُمّ شوق العبدية، هكذا وردت بهذا الاسم في أكثر المصادر، لكن في تاريخ ابن عساكر باسم (أُمّ شرف العبدية)[251]، وفي سير أعلام النبلاء باسم (أُمّ سوق)[252].
ولم نجد فيها جرحاً ولا تعديلاً، ولم نقف على راوٍ عنها غير مسلم بن إبراهيم.
3 ـ نضرة الأزدية، ذكرها ابن حبّان في الثقات، وقال: «نضرة الأزدية من أهل البصرة، تروى عن الحسين بن علي، روى عنها البصريون»[253].
ومن الواضح من عبارة ابن حبّان أنّها كانت معروفة عند أهل البصرة ويروون عنها.
فالسند إذن لا إشكال فيه إلّا من جهة أُمّ شوق العبدية؛ حيث لم نقف لها على توثيق أو تضعيف.
هذا، ويمكن التمسّك بصحة الحديث بناءً على إخراج البيهقي له في دلائله[254]، فقد صرّح البيهقي بأنّه لا يخرّج إلّا الصحيح، وإذا كان الحديث ضعيفاً أشار إليه، فقال في مقدّمته: «ويعلم أنّ كلّ حديث أوردته فيه قد أردفته بما يُشير إلى صحته، أو تركته مبهماً، وهو مقبول في مثل ما أخرجته، وما عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه، وجعلت الاعتماد على غيره»[255].
وقال بعد ذلك: «وعادتي في كُتبي المصنّفة في الأُصول والفروع، الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصحّ منها وما لا يصحّ؛ ليكون الناظر فيها من أهل السنّة على بصيرة ممّا يقع الاعتماد عليه... ومَن وقف على تمييزي في كُتبي بين صحاح الأخبار وسقيمها، وساعده التوفيق، علم صدقي في ما ذكرته»[256].
وقد صرّح الشيخ مصطفى السليماني بتلك القاعدة أيضاً، ورأى أنّ كلام البيهقي صريح في ذلك، فقال بعد أنْ ذكر كلامه: «فهذا يدلّ على أنّ البيهقي ما لم يُضعِّف حديثاً، فهو عنده ممّا يُحتجّ به»[257].
هذا إسناد صحيح، غير أنّ نضرة الأزدية لم نقف لها على توثيق أو تضعيف، إلّا أنّ إخراج البيهقي لها وعدم تعقّب حديثها بتضعيف يدلّ على وثاقتها، بل وصحّة الحديث عنده كما أومأنا إليه قبل قليل.
الخبر الثالث: خبر خليفة بن صاعد
أخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أحمد بن أبي عثمان، وأحمد بن محمد بن إبراهيم.
وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم، نا أبي، أبو طاهر، قالا: أنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله الصرصري، نا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا الحسن بن شبيب المؤدّب، نا خلف بن خليفة، عن أبيه، قال: لمّا قُتل الحسين اسودّت السماء، وظهرت الكواكب نهاراً، حتّى رأيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمر»[258].
وأورده المزي في تهذيبه، قال: «وقال الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدّثنا الحسن بن شيب المؤدّب، قال: حدّثنا خلف بن خليفة، عن أبيه، قال: لمّا قُتل الحسين اسودّت السماء، وظهرت الكواكب نهاراً، حتّى رأيت الجوزاء عند العصر وسقط التراب الأحمر»[259].
من الواضح أنّ ابن عساكر له أكثر من طريق إلى إسماعيل بن الحسن الصرصري، والطريق إليه ثابت بلا شك؛ لذا سنقتصر على طريق واحد من باب التوثيق لا أكثر.
1 ـ أبو القاسم بن السمرقندي: وهو إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي، ترجمه تلميذه ابن عساكر، وقال عنه: «وكان مكثراً ثقةً، صاحب نُسخ وأُصول»[260].
وقال أبو طاهر السلفي: «هو ثقة، له أُنس بمعرفة الرجال، وقال: كان ثقة يعرف الحديث، وسمع الكتب»[261].
2 ـ أحمد بن أبي عثمان وبقرينة رواية ابن السمرقندي عنه وروايته عن الصرصري، فهو ابن منتاب، قال فيه الذهبي: «الإمام الثقة، أبو محمد، أحمد بن أبي عثمان الحسن بن محمد بن عمرو بن منتاب البصري، ثمّ البغدادي، الدقاق، المقرئ، مقرئ مجوّد مكثر، ديّن مهيب، لقنّ جماعة ختموا عليه، مولده سنة (397هـ). وسمع أبا أحمد الفرضي، وإسماعيل بن الحسن الصرصري... روى عنه مكي الرميلي، وهبة الله الشيرازي... وأبو القاسم بن السمرقندي»[262].
3 ـ إسماعيل بن الحسن بن هشام الصراصري: قال الخطيب: «سألت البرقاني عنه، فقال: صدوق. وسُئل عنه، وأنا أسمع، فقال: ثقة»[263]. ووصفه الذهبي بأنّه: «أحد الثقات»[264]. وقال السمعاني: «شيخ صدوق ثقة»[265]. وقال ابن الأثير: «كان ثقة»[266].
4 ـ الحسين بن إسماعيل المحاملي: أحد الحفّاظ والمحدّثين المعروفين، ثقة بلا كلام.
5 ـ الحسن بن شبيب المؤدّب: حدّث عنه جملة من الحفّاظ وأهل الحديث: كأبي يعلى الموصلي، والقاضي المحاملي، ويعقوب بن شيبة السدوسي، والهيثم بن خلف، ويحيى بن محمد بن صاعد، وغيرهم[267]، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «ربّما أغرب»[268]. وقال عنه ابن المقرئ: «كان يوثق»[269]. وقال عنه المحاملي: «من ثقات أهل بغداد»[270]. وقال عنه الدارقطني: «إخباري يعتبر به، وليس بالقوى، يُحدّث عنه المحاملي»[271].
لذا فإنّ قول ابن عدي بأنّه يحدّث عن الثقات بالبواطيل[272] بعيد للغاية، ولا مبرر ولا دليل على إلصاق تلك البواطيل به ما دام موثّق حاله حال غيره، فلربّما كانت البواطيل من غيره وليست منه، فتلامذته وهم أعرف الناس به، وكذلك مَن كانوا في عصره كانوا يوثّقونه، وقولهم حينئذٍ يُقدّم على قول غيرهم.
نعم، لأجل قول ابن حبّان: (ربّما أغرب)، وقول الدارقطني بأنّه: (ليس بالقوي)، فالرجل ينزل عن مرتبة الثقة إلى الصدوق ويكون حديثه حسناً.
6 ـ خلف بن خليفة: من رجال البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة، له ترجمة في تهذيب الكمال، ونقل عدّة أقوال في مدحه، منها:
«قال عباس الدوري، وعبد الخالق بن منصور، وأبو بكر ابن أبي، عن يحيى بن معين: ليس به بأس. وكذلك قال النسائي، وزاد عبد الخالق: صدوق. وقال محمد بن عبد الله بن عمّار: لا بأس به، ولم يكن صاحب حديث. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو أحمد بن عدي: أرجو أنّه لا بأس به، ولا أُبرئه من أن يُخطئ في بعض الأحايين في بعض رواياته. وقال محمد بن سعد: كان ثقة»[273].
وقال العجلي: «ثقة»[274].
ويظهر من بعض الأقوال أنّه تغيّر في آخر عمره؛ بسبب الفالج الذي أصابه، لكن ذلك لا يمنع من التمسّك بحديثه؛ لذا فإنّ الذهبي قال عنه: «صدوق»[275]، مع وقوفه على جميع الكلمات التي قيلت فيه[276].
7 ـ خليفة بن صاعد: من التابعين، ذكره ابن حبّان في الثقات[277]، وقال فيه ابن حجر: «صدوق»[278].
تبيّن من خلال دراسة الرجال أنّ هذا السند حسن لذاته، ولو تنزلنا وقلنا بضعف الحسن بن شبيب المؤدّب، فلا شكّ في صلاحيته في المتابعات والشواهد؛ إذ لا يمكن إغفال عدّة توثيقات وردت بحقّه من معاصريه وتلامذته، فيتقوّى بغيره من الأخبار الواردة في الحادثة.
الطائفة الثانية: الأخبار التي لم يثبت اعتبارها لكنّها تؤيِّد وقوع الحادثة
أورده المزي، قال: «قال أبو القاسم البغوي: حدّثنا قطن بن نسير أبو عبّاد، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان، قال: حدّثتني خالتي أُمّ سالم، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مُطرنا مطراً كالدم على البيوت والجدر، قال: وبلغني أنّه كان بخراسان والشام والكوفة»[279].
وأخرجه ابن عساكر من طريق البغوي[280]. وأورده الطبري في ذخائره، وقال: «خرّجه ابن بنت منيع»[281]. وابن بنت منيع هو أبو القاسم البغوي.
وأخرجه ابن العديم من طريق آخر عن جعفر، عن أُمّ سالم أيضاً، قال: «أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي، قال: حدّثنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن بن نصر البسطامي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التاجر الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر الكاغذي، قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي الجمّال، قال: حدّثنا بشر بن موسى الأسدي، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا جعفر، عن أُمّ سالم...». فذكره، وأضاف في آخره: «حتّى كنّا لا نشكّ أنّه سينزل عذاب»[282].
وأخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزار (شيخ الحنفية بنيسابور)[283] في كتاب الفتن على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا إسحاق بن موسى، قال: حدّثنا المقدّمي، قال: حدّثنا جعفر، قال: حدّثتني خالتي أُمّ سالم بنت مسلم، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مُطرنا كالدم على البيوت والجدر، فبلغنا أنّه كان بالشام والكوفة وخراسان»[284].
ويبدو أنّ أُمّ سالم صحّفت عند الصالحي الشامي فذكر أنّ الراوي المباشر هو أُمّ سلمة، فروى عن جعفر بن سليمان أنّه قال: حدّثتني خالتي أُمّ سلمة[285].
فالسند كما هو واضح يدور على جعفر بن سليمان وخالته أُمّ سالم؛ لذلك حين أورده الذهبي، قال: «قال جعفر بن سليمان»[286].
لكن مع ذلك سنقوم بدراسة الخبر الذي ذكره أبو القاسم البغوي: «حدّثنا قطن بن نسير أبو عبّاد، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان، قال: حدّثتني خالتي أُمّ سالم،...».
أمّا البغوي، فهو (عبد الله بن محمد) ثقة معروف من كبار أئمّة الحديث[287].
وقطن بن نسير، احتجّ به مسلم، وروى عنه أبو داوُد وغيره، وقال ابن حجر وتبعه الألباني: «صدوق يُخطئ»[288]. فحديثه حسن، لكنّه لم ينفرد، بل تابعه عبد الله بن أبي بكر المقدّمي، وخالد بن خدّاش كما تقدّم في التخريج.
أمّا جعفر بن سليمان، فهو ثقة من رجال مسلم والأربعة، والبخاري في الأدب المفرد، وله ترجمة مُفصّلة في التهذيب ذكر فيها عدّة من الكلمات فيه، والظاهر أنّه لم يؤخذ عليه غير التشيّع[289].
وخلاصة الآراء فيه: إنّ الرجل إمّا ثقة أو صدوق، قال الذهبي: «ثقة فيه شيء مع كثرة علومه، قيل: كان أُميّاً، وهو من زهّاد الشيعة»[290]. وقال ابن حجر: «صدوق زاهد، لكنّه كان يتشيّع»[291]. وقال الألباني: «هو ثقة من رجال مسلم»[292].
أمّا خالته أُمّ سالم، فلم أقف لها على ترجمة.
والخلاصة: إنّ السند ضعيف؛ لجهالة أُمّ سالم، لكنّه يتقوّى بما تقدّم، وبما سيأتي من أخبار مؤيِّدة للحادثة.
أخرجه الدولابي، قال: «أخبرني أبو عبد الله الحسين بن علي، قال: حدّثنا أبو محمد الحسن بن يحيى بن زيد بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، قال: حدّثنا حسن بن حسين الأنصاري، عن أبي القاسم مؤذِّن بني مازن، عن عبيد المكتب، عن إبراهيم النخعي، قال: لمّا قُتل الحسين احمرّت السماء من أقطارها، ثمّ لم تزل حتى تقطرّت، فقطرت دماً»[293].
وأخرجه من طريقه ابن العديم في بُغيته[294].
1 ـ أبو عبد الله، الحسين بن علي: قد بحثت عن هذا الراوي كثيراً، ولم أستطع في بادئ الأمر أنْ أتعرّف عليه، فإنّ الأسماء متشابهة جدّاً، وقد خفي على محقّق كتاب (الذرّية الطاهرة) أيضاً، وذكر أنّه لم يهتدِ إليه[295]، ثمّ تبيّن لي بعد ذلك أنّ الحسين بن علي هذا، والذي هو شيخ الدولابي، هو الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو شيخ ابن عدي أيضاً سمع منه بمصر[296]، ووسمه بأنّه: «شيخ أهل البيت بمصر»[297]. وكان يُعدّ من أفضل أهل زمانه، فعن أبي سعيد الطبري، قال: «أنشدني الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي (رضي الله عنه) لنفسه، وكان أفضل أهل زمانه»[298]، ثمّ وقفت على تعديل الدارقطني له، فقد جاء في سؤالات حمزة للدارقطني: «وسألته عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بمصر، فقال: ليس به بأس»[299].
2 ـ الحسن بن يحيى بن زيد، لم أقف له على ترجمة بعد طول بحث.
3 ـ حسن بن حسين الأنصاري، وهو المعروف بحسن بن حسين العرني، صحّح له الحاكم في المستدرك[300].
وأخرج له البيهقي في السنن وسكت عنه[301]، والبيهقي صرّح بأنّه إذا أورد إسناداً فيه ضعف أشار إليه[302]، ولم نرَ منه إشارة إلى تضعيف الحسن هذا، فهو مقبول الحديث عنده.
وقد ضعّفه عدّة من العلماء:
قال أبو حاتم: «لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة»[303].
وذكر ابن حبّان أنّه: «شيخ من أهل الكوفة، يروي عن جرير بن عبد الحميد والكوفيين، المقلوبات»[304].
قلت: أبو حاتم، وابن حبّان كلاهما متشدّد في الجرح، وابن حبّان يقصب الراوي بالغلطة والغلطتين، وجرح أبي حاتم غير مفسّر، والحسن هذا من رؤساء الشيعة، فكان طبيعياً أنْ يُضعّف.
فالتضعيف لم يكن مستنداً إلى أمر صحيح، بل هو مستند إلى العقيدة لا غير، والجرح المستند إلى العقيدة لا يؤخذ به.
4 ـ أبو القاسم، مؤذن بني مازن، أمّا بنو مازن، فهم قبيلة معروفة، ومنهم التابعي عتبة بن غزوان، ومؤذنهم هذا لم أقف على اسمه، لكن يمكن القول أنّ نفس كونه مؤذن للعشيرة يعطيه نوع من القوّة، ولربما لشهرته في وقته، فإنّ الراوي لم يصرّح باسمه واكتفى بكونه مؤذن بني مازن.
5 ـ عبيد المكتب: وهو عبيد بن مهران المكتب، من رجال مسلم، ثقة لا كلام فيه، قال يحيى بن معين: «ثقة»[305]. وقال أبو حاتم: «ثقة صالح الحديث»[306].
وكذلك وثقه النسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، وابن سعد، وذكره ابن حبّان في الثقات[307].
6 ـ إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من رجال الستّة، وهو: فقيه ثقة كما قال ابن حجر[308]. «وكان عجباً في الورع والخير، متوقياً للشهرة، رأساً في العلم» كما قال الذهبي[309].
اتّضح أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة الحسن بن يحيى بن زيد، وكذلك جهالة مؤذن بني مازن، لكن ضعفه ضعفاً خفيفاً يمكن أنْ يصلح في المتابعات والشواهد.
أخرجه الحلبي، قال: «أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن أبي الحسن بن المقير البغدادي النجار بالقاهرة المعزية، قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد إجازة، قال: أنبأنا أبو إسحق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الحبال الحافظ، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عمر الناقد، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سليمان المعروف بالطبري الأنصاري، قال: حدّثنا أبو علي ـ يعني ـ هارون بن عبد العزيز بن هاشم الأنباري المعروف بالأوارجي، قال: حدّثنا عمر بن سهل، قال: حدّثنا أحمد بن محمد الجمّال، قال: قرأت على أحمد بن الفرات، قال: حدّثنا محمد بن الصلت، عن مسعدة، عن جابر، عن قرط بن عبد الله، قال: مُطرت ذات يوم بنصف النهار فأصاب ثوبي، فإذا دم، فذهبت بالإبل إلى الوادي فإذا دم، فلم تشرب، وإذ هو يوم قتل الحسين (رحمة الله عليه)»[310].
وحيث إنّ سلسلة السند طويلة جدّاً، وقلّ ما تجد مَن قدح في المشايخ المتأخرين؛ لذا سنبدأ ترجمة الرواة من منتصف السند إلى الراوي المباشر، فإنْ صحّ السند أكملنا دراسته، وإنْ لم يصح، فلا نجد ضرورة لإكماله، فنقول:
1 ـ أحمد بن محمد الجمّال: وهو كما ذكره الخطيب: «أحمد بن محمد بن عبد الله بن مصعب، أبو العباس الجمّال، من أهل أصبهان، أحد مَن كان يُذكر بالعلم، ويُوصف بالفضل»[311].
وقال عنه أبو نعيم: «أحد العلماء والفقهاء»[312].
وقد روى عنه جمع من الثقات، فهو ثقة وفق المباني.
2 ـ أحمد بن الفرات: وهو أبو مسعود الرازي، ثقة حافظ معروف، له ترجمة في تهذيب التهذيب، ذكر فيها ابن حجر عدّة من التوثيقات في حقّه، والرد على ابن خراش الذي تكلّم عنه بلا دليل[313]؛ ولذا قال في التقريب: «ثقة حافظ تُكلّم فيه بلا مستند»[314]. وقال الذهبي: «الحافظ الثقة»[315].
3 ـ محمد بن الصلت الثوري أو التوزي: قال فيه أبو حاتم: «صدوق، كان يُملى علينا من حفظه التفسير وغيره، وربّما وهم»[316]. وقال أبو زرعة: «صدوق»[317]. وذكره ابن حبّان في الثقات[318]. وقال الدارقطني: «ثقة»[319]. وذكره الذهبي في الميزان ووثقه[320].
4 ـ مسعدة: لم أقف عليه، ولم يتبيّن لي مَن هو.
5 ـ جابر: لم أقف عليه أيضاً.
نعم، لربّما ـ والله أعلم ـ أنّ هناك تصحيف، وأنّ الراوي هو مسعدة بن جابر، وليس مسعدة عن جابر، ومسعدة بن جابر ذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل وسكت عنه[321].
وقد تقدّم في رواية سليم القاص أنّ سكوت ابن أبي حاتم عن الراوي يُعدّ توثيقاً عند جملة من العلماء.
6 ـ قرط بن عبد الله: لم أقف على ترجمة له أيضاً.
والخلاصة: إنّ هذا السند ضعيف؛ لوجود عدّة مجاهيل فيه.
أخرجه ابن الجوزي، قال: «أخبرنا علي بن عبيد الله، أخبرنا علي بن أحمد السري[322]، أنبأنا عبد الله بن بطّة[323]، حدّثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، حدّثنا هلال بن بِشرٍ، حدّثنا عبد الملك بن موسى، عن هلال بن ذكوان، قال: لمّا قُتل الحسين، مُطرنا مطراً بقي أثَره في ثيابنا مثل الدم»[324].
وأخرجه ابن العديم، قال: «قرأت بخطّ أبي عبد الله الحسين بن خالويه في بعض أماليه، حدّثنا البعراني ـ يعني أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي ـ قال: حدّثنا هلال ـ يعني ـ بن بشر قال: حدّثنا عمر بن حبيب القاضي، عن هلال بن ذكوان، قال: لمّا قُتل الحسين مُطرنا مطراً بقي أثره في ثيابنا مثل الدم»[325].
1 ـ الحسين بن أحمد بن خالويه: وثّقه أبو عمرو الداني، وقال: «كان ابن خالويه عالماً بالعربية حافظاً للغة، بصيراً بالقراءة، ثقةً مشهوراً، روى عنه غير واحد من شيوخنا: عبد المنعم بن غلبون، والحسن بن سليمان، وغيرهما»[326]. وقال الذهبي: «وكان صاحب سنّة»[327].
2 ـ محمد بن هارون الحضرمي، أبو حامد: حدّث عنه عدّة من حفّاظ الحديث وثقاتهم، وذكره يوسف بن عمر القوّاس في شيوخه الثقات، وسُئل عنه الدارقطني، فقال: «ثقة»[328].
3 ـ هلال بن بشر المزني: قال فيه النسائي: «ثقة»[329]. وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «مستقيم الحديث»[330]. ووثّقه الذهبي[331]، وابن حجر[332].
4 ـ عمر بن حبيب القاضي: فهو إنْ كان اليمني، فهو من كبار التابعين، نصّ على توثيقة عدّة من العلماء[333]، وقال فيه ابن حجر: «ثقة حافظ»[334].
وإنْ كان هو البصري، فقد اختلفت الكلمات فيه، وبنى بعضهم على الأخذ بروايته، في حين ضعّفه فريق آخر، لكن المتابع للكلمات سيصل إلى نتيجة أنّ الرجل وسط الحديث صدوق، وإنّ الذين توقّفوا فيه نتيجة لقوله بالرأي، وهذا ما صرّح به الساجي حين قال: «يهمّ عن الثقات وكان قاضيا، وكان من أصحاب عبيد الله بن الحسن عنه أخذ، فأظنهم تركوه لموضع الرأي، كان صدوقا ولم يكن من فرسان الحديث»[335].
ولذا قال فيه ابن عدي: «هو حسن الحديث، يُكتب حديثه مع ضعفه»[336].
5 ـ هلال بن ذكوان: لم أقف له على ترجمة.
تنويه: قد ورد الخبر بطريق ابن الجوزي، عن هلال بن بشر المزني، عن عبد الملك بن موسى، عن هلال بن ذكوان، ولم يرد عن طريق هلال، عن عمر بن حبيب القاضي، فإمّا أنْ يكون لهلال بن بشر فيه شيخان، وهذا ما يزيد الحديث قوّة، أو يكون قد اختلف على هلال، ويكون الراوي عنه هلال ـ في الواقع ـ هو واحد وغير متعدّد، فإنْ كان هو القاضي، فقد تبيّن أنّه إمّا ثقة أو صدوق؛ لكونه مشترك بين اثنين، وإنْ كان هو عبد الملك بن موسى، فهو مجهول لم يرد فيه جرح ولا توثيق.
قال فيه الذهبي: «لا يُدرى مَن هو، وقال الأزدي: منكر الحديث»[337].
أقول: أمّا قول الأزدي (منكر الحديث)، فلا يمكن الأخذ به؛ لأنّ الأزدي بنفسه ضعيف ولا يعتمد على قوله، مضافاً لكونه متعنّت متشدّد في الرجال، فلا يُعتمد على قوله، قال ابن حجر: «قدّمت غير مرّة أنّ الأزدي لا يُعتبر تجريحه؛ لضعفه هو»[338]. وقال الذهبي: «وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنّف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى، وجرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلّم فيهم، وهو المتكلَّم فيه»[339]. وقال في موضع آخر: «ليت الأزدي عرف ضعف نفسه»[340].
وقال الألباني موثّقاً رجلاً، قال فيه الأزدي (منكر الحديث). وقد روى عنه جمع من الثقات: «فمثله ممّا تطمئن النفس لحديثه؛ لرواية هذا الجمع من الثقات عنه، دون أنْ يعرف بما يسقط حديثه، وأمّا قول الأزدي: (منكر الحديث) فممّا لا يُلتفت إليه؛ لأنّه معروف بالتعنّت في التجريح»[341].
وإذا ما عرفنا أنّ عبد الملك هذا روى عنه عدّة من الثقات، وهم: هلال بن بشر ـ كما في السند المتقدّم[342] ـ وعبيد الله بن يوسف الجبيري[343]، وسوار بن عبد الله[344]، فيكون الرجل حسن الحديث.
ولربّما يكون نفسه المذكور بعنوان عبد الملك الطويل الذي ذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه[345]، ونصّ أبو حاتم على جهالته[346]. وذكره ابن حبّان في الثقات[347].
وفي بعض الأخبار التي ورد فيها عبد الملك هذا برواية هلال بن بشر عنه، علّق الهيثمي قائلاً: «عبد الملك الطويل: وثقه ابن حبّان، وضعّفه الأزدي»[348].
وقد شاءت الأقدار أنْ أتأمّل مجدّداً في عبد الملك بن موسى الطويل بعد مدّة طويلة، فتبيّن لي أنّ الهيثمي قد اشتبه عليه الأمر، وأنّ الاحتمال الذي أوردته فيما سبق من اتحاد عبد الملك هو غير صحيح، فعبد الملك الطويل الذي ذكره البخاري، والرازي، وابن حبّان، إنّما يروي عن عائشة، وعائشة تُوفّيت في سنة (57هـ)، بينما تُوفّي هلال بن بن بشر ـ تلميذ عبد الملك بن موسى ـ في سنة (246هـ)، وحينئذٍ يتّضح أنّ وفاة عبد الملك ستكون في حدود المئتين أو أقل بقليل أو أكثر، فلا يمكن أنْ يروي عن عائشة بأيّ حال من الأحوال.
ويكون عبد الملك بن موسى أبو بشر الطويل، غير عبد الملك الطويل، والله أعلم.
بل يبدو أنّ عبد الملك بن موسى الطويل ـ محلّ البحث ـ غير ذاك الذي ذكره الذهبي، وقال فيه الأزدي (متروك)؛ لأنّ الذهبي ذكر أنّه يروي عن أنس، وهذا لا يمكن أنْ يروي عن أنس بنفس التوضيح السابق، اللّهم إلّا أنْ تكون روايته عن أنس مرسلة، خصوصاً أنّ الرواية التي عثرنا عليها عن أنس يُحتمل في حقّها الإرسال، فقد جاء فيها عن عبد الملك أنّه قال: «كان أنس بن مالك إذا أراد أن يُحدّث عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) تغيّر لونه»[349].
لكن إذا انفتح أمامنا باب الرواية بالإرسال، فيحتمل أنْ تكون رواية عبد الملك الذي ذكره ابن حبّان في ثقاته عن عائشة أيضاً بالإرسال، فيعود احتمال الاتحاد قويّاً، والله أعلم.
والخلاصة: حيث إنّ عبد الملك هذا روى عنه عدّة من الثقات، ولم يثبت تضعيفه، والأزدي بنفسه ضعيف أيضاً، فيكون عبد الملك صدوق حسن الحديث.
هذا السند ضعيف؛ لجهالة هلال بن ذكوان، وهو يصلح للمعاضدة مع غيره من الطرق الأُخرى.
أخرجه ابن طيفور: «عن سعيد بن محمد الحميري أبو معاذ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ـ رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام الأسدي، وقال مرّة أُخرى حذيم، قال: قدِمت الكوفة سنة إحدى وستين، وهي السنة التي قُتل فيها الحسين×، فرأيت نساء أهل الكوفة يومئذٍ يلتدمن مُهتّكات الجيوب، ورأيت علي بن الحسين×، وهو يقول بصوت ضئيل، وقد نحل من المرض: يا أهل الكوفة، إنّكم تبكون علينا فمَن قتلنا غيركم؟! ثمّ ذكر الحديث، وهو على لفظ هارون بن مسلم، وأخبر هارون بن مسلم بن سعدان، قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد البصري، عن يحيى بن الحجاج، عن جعفر بن محمد، عن آبائه^، قال: لمّا أُدخل بالنسوة من كربلاء إلى الكوفة، كان علي بن الحسين× ضئيلاً قد نهكته العلّة، ورأيت نساء أهل الكوفة مشقّقات الجيوب على الحسين بن علي×، فرفع علي بن الحسين بن علي× رأسه، فقال: أَلا إنّ هؤلاء يبكين فمَن قتلنا؟! ورأيت أُمّ كلثوم÷، ولم أرَ خفرة ـ والله ـ أنطق منها، كأنّما تنطق وتُفرغ على لسان أمير المؤمنين×، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فلمّا سكنت الأنفاس، وهدات الأجراس، قالت: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على نبيّه إلى أنْ قالت: أفعجبتم أنْ قطرت السماء دماً، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينظرون ...»[350].
ثمّ قال ابن طيفور: «وحدّثنيه عبد الله بن عمرو، قال: حدّثني إبراهيم بن عبد ربّه بن القاسم بن يحيى بن مقدم المقدمي، قال: أخبرني سعيد بن محمد أبو معاذ الحميري، عن عبد الله بن الرحمن رجل من أهل الشام عن حذام الأسدي قال: ...»[351].
ونقله عن ابن طيفور السيّد البراقي في تاريخ الكوفة، قال: «يُحدّثنا أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور، عن سعيد بن محمد الحميري أبو معاذ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ـ رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام الأسدي، قال:...» وذكر الخبر[352].
وأورده مرسلاً أحمد بن محمد الهمداني، ونسب الخبر إلى جرير بن سيير[353].
وأرسله ابن أعثم في تاريخه عن خزيمة الأسدي[354].
وأورده مرسلاً ابن حمدون في تذكرته[355].
ورواه الخوارزمي، قال: «وذكر أبو علي السلامي، عن البيهقي صاحب التاريخ... قال: وقال بشير بن حذيم الأسدي...»[356]، وذكر الحديث.
من الواضح أنّ رواية البيهقي التي نقلها الخوارزمي مرسلة؛ إذ لم يذكر البيهقي طريقه إلى بشير، وأمّا ابن طيفور فقد نقل القصّة بسندين:
الأوّل: ابن طيفور، عن سعيد بن محمد الحميري أبو معاذ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ـ رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام الأسدي، وقال مرّة أُخرى: حذيم.
الثاني: وأخبر هارون بن مسلم بن سعدان، قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد البصري، عن يحيى بن الحجاج، عن جعفر بن محمد، عن آبائه^.
ثمّ عاد ابن طيفور وذكر سنداً آخر إلا أنّه ينتهي إلى سعيد بن محمّد الحميري ومن بعده، كما أوضحناه فيما تقدّم، فهو يعود في الحقيقة إلى السند الأول، إلا أنّه لم يذكر فيه شعبة، بل ذكر أنّ عبد الله بن عبد الرحمن رواها عن حذام الأسدي.
1 ـ ابن طيفور (ت280هـ): هو «أحمد بن أبي طاهر، أبو الفضل الكاتب، واسم أبى طاهر طيفور، وهو مروروذي الأصل، كان أحد البلغاء، الشعراء، الرواة، ومن أهل الفهم المذكورين بالعلم، وله كتاب بغداد، المصنّف في أخبار الخلفاء وأيامهم، وحدّث عن عمر بن شبة، وأحمد بن الهيثم السامي، وعبد الله بن أبي سعيد الوراق، وغيرهم. روى عنه ابنه عبيد الله، ومحمد بن خلف بن المرزبان، وذكر ابنه أنّه مات في ليلة الأربعاء لأربع بقين من جمادى الأُولى سنة ثمانين ومائتين، ودُفن في مقابر باب الشام، وكان مولده ببغداد مدخل المأمون إليها من خراسان سنة أربع ومائتين»[357].
2 ـ سعيد بن محمد الحميري: لم أقف له على ترجمة.
3 ـ عبد الله بن عبد الرحمن ـ وهو رجل من أهل الشام ـ: أيضاً لم نستطع الوقوف عليه.
3 ـ شعبة: لم يتّضح لنا مَن المقصود به.
4 ـ حذيم: تقدّم سابقاً الخلاف في اسمه عند دراسة خبر السيّدة زينب‘ في كتب الشيعة، وعرفنا أنّه غير موثّق.
تبيّن أنّ هذا السند ضعيف يشتمل على عدّة مجاهيل.
1 ـ هارون بن مسلم بن سعدان: ثقة معروف عند الشيعة الإمامية[358]، ولم نجد له توثيقاً أو جرحاً عند أهل السنّة، وقد ترجمه الخطيب وسكت عنه[359]. فيكون ثقة وفق ما تقدّم عن أبي غدّة بأنّ سكوت هؤلاء يُعدّ أمارة على التوثيق.
2 ـ يحيى بن حمّاد البصري: ثقة عابد[360].
3 ـ يحيى بن الحجاج: هو الكرخي ثقة عند الشيعة[361]، ولم أجد له ذكراً عند أهل السنّة.
4 ـ جعفر الصادق×: أحد الأئمّة عند الشيعة، وثقة جليل القدر، لا يُسئل عن مثله عند أهل السنّة.
تبيّن أنّ هذا السند ضعيف وفق مباني أهل السنّة، فإنّ يحيى بن الحجاج الكرخي لم نقف له على ترجمة عندهم، فهو شاهد جيد تتقوّى به بقيّة الأخبار.
قال الصالحي الشامي: «وروى ابن السدي، عن أُمّ سلمة، قالت: لمّا قُتل الحسين (رضي الله تعالى عنه) مُطرنا دماً»[362].
وفي ذخائر العقبى: «وعن أُمّ سلمة، قالت: لمّا قُتل الحسين مُطرنا دماً»[363].
وذكر بعده أنّ الخبر خرّجه ابن السُّري.
وقال في موضع آخر: «عن أُمّ سلمة، قالت: لمّا قُتل الحسين ناحت عليه الجنّ، ومُطرنا دماً»[364]. وأضاف خرّجه ابن السُّرى.
لكنّنا لم نعثر على كتاب ابن السُّري، وعلى سند الخبر من مصدر آخر، فيكون الخبر مرسلاً من دون سند.
أورده مُرسلاً القندوزي الحنفي، قال: «وعن ابن عباس: إنّ يوم قُتل الحسين× قطرت السماء دماً، وإنّ هذه الحمرة التي تُرى في السماء ظهرت يوم قتله، ولم تُرَ قبله، وإنّ أيام قتله لم يُرفع حجر في الدنيا إلّا وجد تحته دم»[365].
والخبر مرسل كما هو واضح، والمرسل معدود من الأخبار الضعيفة.
أورده القندوزي الحنفي عن أبي مخنف، في قصة طويلة، جاء فيها: «فلمّا جنّ الليل نظر الراهب إلى الرأس الشريف المكرّم رأى نوراً قد سطع منه إلى عنان السماء، ورأى أنّ الملائكة ينزلون ويقولون: يا أبا عبد الله عليك السلام. فبكى، وقال لهم: ما الذي معكم؟ قالوا: رأس الحسين بن علي. فقال: مَن أُمّه؟ قالوا: أُمّه فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى. قال: صدقت الأحبار. قالوا: ما الذي قالت الأحبار؟ قال: يقولون: إذا قُتل نبيّ أو وصي، أو ولد نبيّ أو ولد وصي، تمطر السماء دماً. فرأينا أنّ السماء تمطر دماً، وقال: وا عجباه من أُمّة قتلت ابن بنت نبيّها»[366].
وقد عثرنا على قريب من هذا الخبر في مقتل أبي مخنف (النسخة المشتهرة المنسوبة إليه)، جاء فيه: «فقال الراهب: تباً لكم ولمِا جئتم في طاعته، لقد صدقت الأخبار في قولها: أنّه إذا قُتل هذا الرجل تمطر السماء دماً، ولا يكون هذا إلّا بقتل نبيّ أو وصيّ نبيّ»[367].
وهذا الخبر كذلك مرسل وضعيف.
9 ـ مرسلة سبط ابن الجوزي عن الشعبي
أوردها سبط ابن الجوزي، قال: وقال الشعبي: «لمّا قُتل الحسين اسودّت الدنيا ثلاثة أيام، ورمت السماء رملاً أحمر»[368].
والمرسل محكوم بالضعف.
روايات أُخرى في مطر السماء دماً
بعد أنْ أوردنا عدّة من الروايات الدالة على مطر السماء دماً من كتب الشيعة وكتب أهل السنّة، لا بأس أنْ نذكر عدّة أُخرى من الروايات المرسلة التي ذكرها القاضي النعمان المغربي ـ ولربّما أشار لبعضها غيره ـ والتي نقلها من مصادر مختلفة، لم يتسنَ لنا الوقوف عليها؛ لعدم وصولها إلينا، وبعضها وصلت إلينا أسانيدها من مصادر أُخرى، فذكرناها سابقاً وقمنا بدراستها، وبعضها تفرّد بنقلها لنا القاضي المذكور، ولم يتسنَ لنا معرفة أسانيدها لنقوم بدراستها.
والخلاصة: إنّ هناك عدّة من الأخبار ذكرها القاضي المغربي، لم نقف على مصادرها التي نقلها منها، فيكون هو المصدر الأساس لها، ارتأينا أنْ نفردها هنا لوحدها، وهي كما يلي:
1 ـ خبر يزيد، أو زيد بن أبي الزناد، جاء في شرح الأخبار: «محمد بن الزبير، بإسناده، عن [زيد] بن أبي الزناد، أنّه قال: كنت ابن أربع عشر سنة حين قُتل الحسين (صلوات الله عليه)، فرأينا السماء تقطر دماً، وصار الورس رماداً»[369].
وهذا الخبر أرسله الطبري الشيعي أيضاً في دلائله، قال: «وقال يزيد بن أبي زياد: كنت ابن أربع عشرة سنة حين قُتل الحسين×، فقطرت السماء دماً، وصار على رؤوس الناس الدم، وأصبح كلّ شيء ملآن دماً» [370].
2 ـ خبر أُمّ سالم، جاء في شرح الأخبار: «أسامة بن سمير، باسناده عن أُمّ سالم، أنّها قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي×، مطرت السماء مطراً كالدم، احمرّت منه البيوت والحيطان، فبلغ ذلك البصرة والكوفة، والشام وخراسان، حتى كنّا لا نشك أنّه سينزل العذاب»[371].
وهذا الخبر أورده أيضاً ابن شهر آشوب في المناقب، ونسبه إلى أسامة بن شبيب، بإسناده، عن أُمّ سليم[372].
3 ـ خبر حمّاد بن سلمة، جاء في شرح الأخبار: «محمد بن يوسف بإسناده، عن حمّاد بن سلمة، أنّه قال: مطر الناس ليالي قَتل الحسين× دماً»[373].
4 ـ خبر عمرو بن زياد، جاء في شرح الأخبار: «محمد بن مخلّد، بإسناده، عن عمرو بن زياد، أنّه قال: أصبحت جبابنا يوم قُتل الحسين× ملآنة دماً»[374].
5 ـ خبر نصرة الأزدية، جاء في شرح الأخبار: «محمد بن يوسف، بإسناده، عن نصرة الأزدية، أنّها قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي× مطرت السماء دماً، وأصبح كلّ شيء لنا ملآنا دماً»[375].
وقد تقدّم سابقاً تخريج الخبر ودراسته من مصادر أُخرى، وعرفنا هناك أنّ الراوي المباشر هو (نضرة) بالضاد وليس بالصاد.
إثبات أو نفي نزول المطر بعد مقتل الحسين×
عند التأمّل في ما أوردناه من الأخبار يمكن أنْ نخرج بنتيجة إيجابية، وهي حدوث ذلك الأمر بعد مقتل الحسين×، ويمكن توضيح ذلك من خلال عدّة طرق:
الطريق الأوّل: الدراسة السَنَدية
ولعلّه بملاحظة ما تعرّض له أهل البيت^ من ملاحقة وظلم وتعدي، وما لاقاه مواليهم من إقصاء ومحاربة، تجد من الصعوبة التحدّث والتفوّه بكلّ ما يتعلّق من بعيد أو قريب في الوضع السياسي، سواء ما يرتبط بأحاديث الولاية والخلافة مباشرةً، أو بما يؤدي إلى ذلك، بما فيها الفضائل أو الكرامات التي لها تعلّق واضح بهذا الأمر؛ لأنّ السلاطين أحكموا الأمر وحاولوا القضاء على كلّ ما يمت لأهل البيت^ بصلة، وكلّ الأجواء من أيام بني أُميّة وما جاء بعدها لبني العباس كانت ضدّ خط أهل البيت^؛ لذا من الصعوبة أنْ تجد روايات صحيحة في ذلك.
وطبيعي أنّ مطر السماء دماً وغيرها من الأحداث الكونية تضرب الحكومات السياسية المعادية لأهل البيت^ بالصميم، وتبيّن ظلمها وانحرافها عن جادة الشريعة الإسلامية؛ لذا لم يكن متوقعاً وفي الحسبان أنْ تجد في كتب التاريخ والحديث ما يدلّ على تلك الحوادث بأسانيد صحيحة معتبرة.
لكن رغم أنّ الحكومات كانت بأيديهم، ورغم التقية الشديدة التي يعيشها أتباع أهل البيت^، فقد وصلت بحمد الله بعض الأخبار ذات الأسانيد المعتبرة في كُتب الفريقين، وقد تقدّم ذكرها مفصّلاً، وهي كما يأتي:
أوّلاً: الأخبار المعتبرة عند الشيعة
1 ـ خبر الريّان بن شبيب
2 ـ خبر المفضّل بن عمر
3 ـ خبر عمرو بن ثبيت
ثانياً: الأخبار المعتبرة عند أهل السنّة
1 ـ خبر سليم القاص
2 ـ خبر نضرة الأزدية
3 ـ خبر خليفة بن صاعد
ومنه يتّضح أنّه لو قلنا: إنّ المنهج في ثبوت الأخبار التاريخية الذي يجب أنْ يُتّبع، هو ما عليه أهل الحديث من التصحيح والتضعيف، وأنْ ما صحّ فقد ثبت، وما لم يصح فلم يثبت، فستكون الواقعة ثابتة لمِا أوضحناه من ثبوت بعض الأخبار عند الفريقين.
الطريق الثاني لإثبات الحادثة: تعدّد الطرق
كما عرفنا سابقاً، فإنّ هذه الحادثة لم تروَ بطريق واحد أو طريقين، بل وردت بطرق عدّة، وهي: تسعة طرق عند الشيعة، لكن ثلاثة منها يدوران على نصر بن مزاحم، وعمر بن سعد، فيكون مجموع الطرق في هاتين الطبقتين سبعة، وفي باقي طبقات السند تسعة، فمع ملاحظة وثاقة نصر بن مزاحم، بل وحسن حال عمر بن سعد على ما تقدّم، فإنّه لا يبعد القول بأنّ مجموع هذه الطرق يُشكّل ظنّاً قويّاً يُفيد الوثوق بحصول الحادثة، خصوصاً أنّ هذه الأخبار لا يوجد فيها راوٍ كذّاب أو متّهم بالكذب، بل غاية ما هنالك أنّ بعضهم مهملين لم يردوا في كتب الرجال، أو بعضهم ضعاف لاختلاط ونحوه، وقد تقدّم دراسة تلك الأسانيد واتّضح الحال فيها، وأنّ فيها ثلاثة أخبار معتبرة سنديّاً، فبضمّها لغيرها من الأخبار الضعيفة تزداد نسبة الوثوق بحصول الحادثة.
كما أنّه وردت عدّة طرق عند أهل السنّة، فعدد الرواة للخبر كانوا أحد عشر، بعض الطرق مرسلة لم يصل سندها، والطرق المسندة ناهزت التسعة على تعدد في بعض الطبقات، منها: ثلاثة معتبرة، والبقيّة أكثرها مبتلاة بضعف خفيف قابل للانجبار؛ إذ إنّه وفق مباني وقواعد الحديث عند أهل السنّة فإنّ الخبر الضعيف إذا خلا من كذاب أو متّهم بالكذب ولم يكن شاذّاً، يتقوّى بغيره ويصير المجموع حسناً أو صحيحاً لغيره، بحسب عدد الأخبار كثرة وقلّة، وحيث إنّ الأخبار متعدّدة وبعضها معتبر بنفسه، فلا شكّ أنّها تتقوّى مع بعضها وتبلغ درجة الصحيح لغيره.
وبالجملة فإذا ما نظرنا إلى مجموع الأخبار عند الفريقين، والبالغة تقريباً تسعة عشر طريقاً غير المراسيل التي لم نقف على أسانيدها، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنّ من بين هذه الطرق ما هو المعتبر سنداً، فسنصل إلى نتيجة أنّ مجموع الطرق واختلاف المخارج يورث الاطمئنان بصدور الحادثة.
الطريق الثالث لإثبات الحادثة: إجماع الفريقين على نقلها
وهنا نودّ الإشارة إلى أمر آخر، وهو أنّ هذه الروايات مروية في كتب الفريقين، بمعنى أنّه مع اختلاف العقائد وتباين الآراء والمشارب، ومع ذلك فقد اتفقت كلمة المسلمين من أهل الحديث والتاريخ على نقل هذه الحادثة وتدوينها في المصادر.
فلو أمكن لقائل أنْ يقول: إنّ هذه الحادثة تتماشى مع أهواء الشيعة وتتناغم مع عقيدتهم، فإنّها بلا شكّ لا تنسجم ولا تتناغم مع هوى الطائفة الأُخرى.
ومن الطبيعي أنّ الحادثة ـ أيّ حادثة كانت ـ تكتسب القوّة والتأييد كلّما اتفقت الأطراف المختلفة على نقلها، بغض النظر عمّا إذا اختلفت الأهواء والآراء، فكيف إذا اختلفت فيها الأنظار وكان لها تأثير عقدي كبير؟ فإنّ ذلك يزيدها قوةً وثبوتاً، خصوصاً أنّها تمثّل إقراراً من الطرف المقابل بما يمثّله الحسين× من قيمة عُليا تهتز لها السماء وتمطر دماً لقتله، والإقرار في هكذا أُمور بنفسه يشكّل قرينة كبيرة على صحّة الحادثة ووقوعها؛ إذ لا معنى لأنْ يتعمّد الإنسان الكذب في أُمور لا تصبُّ بمصلحته، وتكون نتيجتها مخالفة لعقيدته.
والخلاصة: إنّ نقل الحادثة من قِبل الفريقين يدفع أيّ شبهةٍ يمكن أنْ تُدّعى بأنّ تلك الأخبار إنّما هي من وضع الشيعة؛ لأنّها تمثّل إقراراً من الطرف المقابل بحصولها.
أضف إلى ذلك أنّه عند الاختلاف في أمر معيّن لا مناص ولا وسيلة حينئذٍ إلّا بالرجوع إلى ما اتّفق عليه الفريقان؛ لأنّه طريق عقلائي يتّضح من خلاله الثابت من غيره، وهذا الطريق العقلائي متحقق في الحادثة المذكورة.
الطريق الرابع: المؤيّدات التاريخية لحصول تلك الحادثة
من المؤيّدات لوقوع هذه الحادثة هو تصريح عدّة من العلماء وأهل السّيَر والتأريخ بحصولها، سواء على نحو الجزم أو بنسبتها إلى الرواة، فإنّ ذلك بنفسه يدلّ على عدم رفضهم لوقوع تلك الحادثة، وأنّها مسألة ممكنة في حدّ ذاتها، وإلّا لو كانت عندهم هذه المسألة غير قابلة للوقوع أو التحقّق فلا معنى لإيرادها وروايتها، وسنحاول هنا أنْ نذكر نماذج لا غير، ممّا أورده أهل التاريخ في خصوص هذه الواقعة:
1 ـ الوثيقة البريطانية
ورد في كتاب يتحدّث عن التاريخ البريطاني، والذي جاء بعنوان: (وقائع عصر الأنغلو ساكسون)، النص الآتي ضمن حوادث سنة (685) للميلاد:
There was in Britain a bloody rain، and milk and butter were turned to blood.
ومعناه: (أنّه من ضمن حوادث عام 685 ـ للميلاد ـ في بريطانيا، مطرت السماء دماً وتحوّل الحليب والزبدة إلى دم)[376].
وقد قيل: إنّه عند مقارنة هذه السنة الميلادية (685) بالعام الهجري، فإنّها تطابق سنة (61) للهجرة، وهي السنة التي استُشهد فيها الإمام الحسين×.
لكن يبدو أنّ هناك جدلاً يتعلّق بمسألة تحويل التاريخ من الميلادي إلى الهجري، فقد قيل أيضاً: إنّ سنة (685م) غير مطابقة لسنة (61هـ)، بل هي موافقة لسنة (65هـ)، أو (66هـ).
وقد أُجيب على ذلك أيضاً: بأنّ هناك تلاعباً حصل في العام الميلادي، وأنّ الصحيح هو المطابقة في التاريخ.
أقول: بغض النظر عن ذلك، فإنّ الوثيقة لا أقلّ من كونها تُثبت أنّ مسألة نزول المطر من السماء هو أمر حصل في البلاد الإنجليزية، أي: إنّ السماء قد تمطر دماً لأسباب وظروف معيّنة، فلمّاذا الاستغراب واستنكار مسألة نزول المطر بعد مقتل الحسين×؟!
2 ـ قول البلاذري:
جاء في مثير الأحزان: « قال البلاذري في مختاره: مطرت السماء دماً يوم قتله، وما قُلع حجر بالشام إلّا وتحته دم عبيط»[377].
3 ـ قول أبي سعيد:
جاء في الصواعق المحرقة: «قال أبو سعيد: ما رُفع حجر من الدنيا إلّا وجد تحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دماً بقي أثره في الثياب مدّة حتّى تقطّعت»[378].
تأمّلات مختصرة في دلالة الأخبار
تبيّن فيما سبق أنّ عدّة من الأخبار نصّت على مطر السماء دماً، وهنا نريد أنْ نتأمّل قليلاً في هذه الأخبار، فهل بالإمكان أنْ تمطر السماء دماً؟ وهل كان المطر هو دماً حقيقيّاً أم كان هناك تحوّلاً واضطراباً كونياً احمرّت لأجله السماء والأرض؟ وهل تُعدّ هذه الحادثة فريدة من نوعها أم قد تكون حدثت في أزمنة أُخرى؟ وهل أنّ المطر شمل جميع العالم أم كان بأنحاء معيّنة؟ وإذا كان بجميع العالم فلمّاذا لم يصلنا بصورة متواترة؟
ثمّ ما هي الدلالات الخاصّة التي يمكن أنْ تُستفاد من هذه الأخبار؟
في الحقيقة لو تأملنا في أصل قضية المطر وضمن الموازين الطبيعية، وحسب القواعد الجغرافية، فإنّ السماء لا يمكن أنْ تمطر دماً؛ لأنّ المطر كما هو معلوم كظاهرة طبيعية يتولّد وينشأ من تبخّر المياه وتحوله إلى غيوم، ثمّ تتكثف وتنزل مطراً، فلا يمكن حينئذٍ أنْ يكون النازل من السحاب هو دم، وحينئذٍ إمّا أنْ نتعامل مع الظاهرة وفق الإعجاز الكوني، ونقول بإنّ ما حاصل بعد عاشوراء كان ظاهرة إعجازية خارج عن نواميس ونظم الطبيعة، أو نفسّر ما حصل بشكل آخر يتناسب مع الظواهر الطبيعية.
وعند التأمّل في لسان الروايات المتعدّدة الواردة في الموضوع، تبرز أمامنا بعض الاحتمالات:
1 ـ أنْ تكون ظاهرة المطر ظاهرة طبيعية، لكن صاحبتها تغيّرات كونية عديدة من شدّة الرياح، وانتشار الغبار، واحمرار الكون، فنزل ما نزل من المطر مصطبغاً باللون الأحمر؛ نتيجة كثرة الغبار الأحمر، بل وتغيّر صورة الكون بأكمله، وهذا الاحتمال يساعد عليه ما ورد من الأخبار الدالة على مطر السماء تراباً أحمر.
2 ـ أنْ يكون ما نزل من السماء دماً عبيطاً حقيقيّاً، ولا دخل للغبار والتغيّرات الكونية في مشاهدته كذلك، ويساعد على هذا الاحتمال ما دلّ صريحاً على مطر السماء دماً، وفي بعضها دماً عبيطاً.
3 ـ إجتماع تلك الحالات معاً، فمع احمرار الكون وشدّة الغبار مطرت السماء دماً أيضاً، بحيث أصبحت الحالة ما تشبه العاصفة الشديدة المخيفة، التي يتخوّف معها الإنسان من نزول العذاب، واقتراب العقاب، ونحو ذلك. ويساعد على ذلك ويدلّ عليه ما ورد من اجتماع الأمرين معاً في لسان بعض الروايات، أعني: مطر السماء دماً وتراباً أحمر، بل يمكن أنْ يساعد عليه أيضاً الجمع بين الروايات المصرّحة بالتراب على حدة، والروايات المصرّحة بالدم على حدة أُخرى.
فنحن إذن أمام ثلاث احتمالات تلوح في الذهن، يمكن أنْ نستفيدها من خلال الأخبار المتقدّمة.
أمّا الاحتمال الأوّل:
وهو عدم نزول المطر الحقيقي، فلا تساعد عليه الأخبار سوى خبراً واحداً عند الشيعة، دلّ على أنّ ما نزل كان تراباً أحمر، وهو خبر محمد بن سلمة عمّن حدّثه، والذي جاء فيه: «لمّا قُتل الحسين بن علي÷ أمطرت السماء تراباً أحمر».
وخبراً ورد عند أهل السنةّ، وهو خبر خليفة بن صاعد حيث ورد فيه: «وسقط التراب الأحمر».
أمّا الخبر الوارد عند الشيعة، فهو ضعيف من الجهة السندية كما تقدّم، مضافاً لتنافيه مع بقيّة الأخبار، فحمل هذا الخبر على الدم أولى من توجيه بقيّة الأخبار على ضوئه؛ إذ من المحتمل قويّاً أنّ الراوي اشتبه عليه الأمر بعد أنْ رأى أُمور الكون قد تغيّرت، فظنّ أنّ الذي نزل هو تراباً أحمر.
على أنّ نزول التراب الأحمر لا يتنافى مع مطر السماء دماً؛ إذ لا تنافي بين الأمرين كما لا يخفى، إلّا أنْ يقال بإنّ مراد الراوي أنْ يبيّن ما حصل من أُمور غريبة في ذلك اليوم، فلا بدّ له من ذكر الدم لو حصل ذلك.
وأمّا الخبر الوارد عند أهل السنّة، فهو معتبر السند كما تقدّم، لكنّ الكلام فيه هو نفس الكلام في نظيره.
وأمّا الاحتمال الثاني:
وهو أنّ السماء مطرت دماً حقيقيّاً، فهو الذي صرّحت به عدّة من الأخبار، ولا مبرر لتأويلها وصرف النظر عن دلالتها، سوى أنّها تتحدّث عن حالة إعجازية خارج أُطر وقوانين الطبيعة، والإعجاز ليس بعزيز إذا تحقّق ما يبرّر وجوده، وفي المقام كانت هناك حملة كبيرة من التشويه على الثورة الحسينية أوّلاً، وتعتيم على مقام الحسين ثانياً، وحجم الجريمة التي ارتكبت ونوعيتها ثالثاً، كلّ ذلك كان مبرّراً لحصول كرامات وخوارق للطبيعة بعد مقتله×، وسوف نتكلّم عن ذلك عند البحث عن الدلالات العامّة التي تقتضيها مجمل الأحداث الكونية التي حصلت بعد عاشوراء.
وأمّا الاحتمال الثالث:
وهو اجتماع الدم مع الرماد والتراب الأحمر، فهو متحقّق أيضاً؛ ذلك أنّ بعض الأخبار صرّحت بنزول التراب والمطر معاً، ومع ملاحظة بقيّة الأخبار التي سنذكرها في الفصول اللاحقة من احمرار السماء، وتغيّر الكون، يتبيّن أنّ هناك أُموراً مجتمعة قد حصلت في ذلك اليوم.
كما أنّ نزول التراب والدم معاً صرّح به الإمام الرضا× في الرواية الأُولى التي ذكرناها، وهي رواية صحيحة معتبرة سنداً، وأخبر عنه مسبقاً الإمام الحسن×، وهي الرواية الثانية التي ذكرناها، وهي معتبرة من حيث السند أيضاً.
أضف إلى ذلك، فإنّ الروايات الدالّة على مطر السماء دماً من دون اقترانها بنزول التراب الأحمر، لا تتنافى مع الروايات الدالّة على نزول التراب الأحمر من دون اقترانها بالدم، بل يمكن الجمع والتوفيق بينهما بأنْ نقول: إنّ كلا الأمرين حصلا معاً، وكلّ راوٍ أخبر عمّا فهمه ممّا رآه في ذلك اليوم المهول.
وأمّا ما يتعلّق بتحقّق هكذا أمر، وهل له نظير في التاريخ، أم أنّه لم يتحقّق أبداً في غير ذلك اليوم؟ فالظاهر من كتب التاريخ أنّ الحادثة لها مثيل في التاريخ، وإنْ كانت حالات نادرة جدّاً، لكنّها قضية موجودة، فقد ذكر السيوطي أنّه: «أخرج أحمد في الزهد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن سعيد بن جبير، قال: غَشِىَ قوم يونس العذاب كما يُغشى القبر بالثوب، إذا أُدخل فيه صاحبه، ومطرت السماء دماً»[379]. وفي وقعة صفّين سنة (37هـ) ذكروا أنّ السماء مطرت دماً أيضاً، قال ربيعة بن لقيط (من ثقات التابعين): «مطرت السماء عليهما دماً، كانوا يأخذونه بالآنية»[380]. وذكر أهل التاريخ في حوادث سنة (246هـ) نزول المطر دماً في بلخ، قال الذهبي: «وفيها مطرت بناحية بلخ مطراً دماً عبيطاً»[381].
و ذكر ابن تغري في حوادث سنة (545هـ)، أنّها مطرت دماً في اليمن، قال: «فيها مُطرت اليمن مطراً دماً، وبقي أثره في الأرض وفي ثياب الناس»[382]. وهكذا ربّما يجد المتتبّع حالات أُخرى.
ومنه يتبيّن أنّ هذه الحادثة لها حصول منذُ قوم يونس حين سلّط الله عليهم العذاب، وقد تكرّرت بعض المرّات، فلا عجب ولا غرو أنْ تحصل في يوم عاشوراء.
وأمّا ما يتعلّق بالمساحة المكانية التي نزل فيها المطر، وهل أنّها شاملة لجميع العالم أم مختصة بمنطقة معيّنة؟ فهذا غير واضح من الروايات، فإنّ أغلب الرواة ذكروا أنّ السماء مطرت دماً، وطبيعي أنّهم يخبرون عمّا شاهدوه في مناطقهم ومدنهم التي يسكنون بها، ولا يمكن أنْ يُخبروا عن جميع مناطق العالم سوى ما يصلهم من خبره، وفي هذا الصدد صرّح بعض الرواة بحسب ما بلغهم أنّ المطر كان في خراسان، والشام، والكوفة.
نعم، ما ورد في روايات أهل البيت^ لم يُقيّد بمنطقة معيّنة، فلعلّه مجملاً من هذه الجهة، وهو أنّ السماء مطرت في الجملة، فنزول المطر دماً في منطقة معيّنة ينطبق على قول الإمام بأنّها مطرت دماً، فلا يمكن حينئذٍ التمسّك بالإطلاق والقول إنّ المطر شمل جميع العالم، فلربّما يكون شاملاً لجميع العالم ولربما يكون مخصوصاً في مناطق معيّنة.
إلّا أنّه بلحاظ نوع الحركة الحسينية، وكونها تهدف إلى إحياء الدين وإعادة الروح المحمّديّة إلى الأُمّة، وباعتبار مكانة الإمام الحسين× الكبيرة في عصره، بل هو إمام الأُمّة الواقعي، وأقرب الناس في عصره إلى النبي’، فإنّه ابن بنته، وباعتبار عِظم المصيبة وحجم المأساة، وكبر الجريمة والظلم المنقطع النظير، الذي تعرّض له الإمام الحسين× وعياله، فمن الطبيعي جدّاً أنْ يهتز الكون بأجمعه لأجل ما جرى من هول المصاب، فلا معنى لانحصاره في مكان معيّن، فالمقتول يمثّل إمام العالم بأجمعه وابن بنت نبي هذه الأُمّة، والجريمة اُقترفت بشكل فظيع، وما حدث كان أشبه بنزول العذاب على الأُمّة، فلا يبعد أنْ تمطر السماء دماً في جميع العالم؛ ولذا جاءت روايات أهل البيت مطلقة ولم تقيّده بمكان معيّن.
أمّا ما يمكن قوله من أنّ هذا الحدث إذا كان حصل في جميع العالم، فكيف لم يصل إلينا بصورة متواترة؟
والجواب عن ذلك أنْ نقول: إنّ جملة من الأسباب قد ساهمت وساعدت على عدم نقله، أو وصوله إلينا بصورة متواترة، منها:
1 ـ إنّ يزيد وزبانيته كانوا قد أحكموا القبضة على العالم الإسلامي، خصوصاً بعد مقتل الحسين×، فإنّ النفوس وإنْ كانت قد تحررت نوعاً ما، إلّا أنّها لم تستطع البوح بكلّ ما شاهدته وعرفته؛ خوف القتل والتنكيل، وهذا أمر معروف من زمن علي×، حينما بلغ بالرواة الخوف من ذكر اسم علي× إلى درجة أنْ يقول بعضهم: حدّثني أبو زينب ولا يصرّح باسمه خوفاً وقرفاً من معاوية وجنوده.
2 ـ إنّ الحكومات المتتابعة من ذلك الزمان وإلى اليوم، إنّما هي حكومات على خلاف هوى ومشرب أهل البيت^، والكثير من كتب التاريخ والحديث كُتبت تحت أنظارهم، وأنّ مَن كتبها أيضاً كان يحمل عقيدة مخالفة لأهل البيت^، فكان طبيعياً أنْ يطمس كلّ ما له علاقة بأهل البيت وإمامتهم وكراماتهم، ولولا أنّ أمرهم وما ورد بحقّهم كان بمستوى من الكثرة والوضوح لمَا وصل شيء منه في كتبهم، لكن وصول الأخبار عنهم هنا وهناك ينبؤك أنّ ما كان موجوداً ولم يُنقل إنّما هو أضعافاً مضاعفة.
3 ـ إنّ كُتب التراث وكما هو معلوم وواضح لدى الجميع، لم تصل بأجمعها إلينا سواء كانت تابعة للتراث السنّي أو التراث الشيعي، فالكثير منها غاب أو غُيّب ولا يستطيع أحداً أنْ يدّعي أنّ ما بين أيدينا يمثّل جميع التراث الإسلامي، خصوصاً التراث الشيعي منه، فإنّ المكتبات الشيعية الضخمة تعرضّت للحرق والنهب وألقيت في الأنهار، وضاع معها الكثير من التراث؛ لذا لا يمكن الادّعاء بأنّه لو كان لهذه الحادثة أصل ثابت لوصل بكثرة، فإنّه من الممكن أنْ يكون قد كُتب وأُثبت لكنّ الكُتب للأسف لم تصل.
والخلاصة: إنّ نفس ورود هذه الحوادث بهذا المقدار، مع النظر للأسباب أعلاه، يكشف عن ثبوتها وتحققها خارجاً، وإذا كانت هذه الحوادث مع ورودها بهذا القدر فهي غير ثابتة، فحينئذٍ علينا أنْ ننسف التأريخ الإسلامي من الأساس؛ لأنّ الكثير من حوادثه لم تصلنا بهذه الكثرة، ومع ذلك يتمسّك بها العلماء ويرتبون الآثار عليها.
وأمّا الدلالات الخاصّة التي يمكن أنْ نستفيدها من نزول المطر فعديدة، منها: إنّ مطر السماء دماً يمثّل حالة البكاء التي حصلت من السموات والأرض على الحسين×، فالمطر حينئذٍ يمثّل حالة الحزن الشديد الحاصلة على الحسين×، والتي بلغت حدّاً أنْ تبكي عليه السماء والأرض، وسيأتي لاحقاً بيان الروايات الدالّة على البكاء، ونبيّن الموضوع بصورة أكثر هناك، ونوّضح معنى بكاء السموات والأرض بصورة أجلى.
وقد أشار ونوّه إلى هذا المعنى الشيخ المجلسي&، حيث قال في توجيهه لبكاء السموات والأرض: «ويمكن أنْ يقال: كناية عن شدّة المصيبة حتّى كأنّه بكى عليه السماء والأرض، أو عن أنّه وصل ضرر تلك المصيبة إلى السماء والأرض وأثّرت فيهما، وظهر بها آثار التغيّر فيهما، أو أنّه أمطرت السماء دماً، وكان يتفجّر الأرض دماً عبيطاً، فهذا بكاؤهما كما فسّر به في الخبر، ولعلّ الأخير أظهر»[383].
كما أنّ إدراج الشيخ ابن قولويه& روايات نزول المطر تحت باب (بكاء السماء والأرض على قتل الحسين×، ويحيى بن زكريا×) يُشير إلى أنّه يرى أنّ المطر دماً كناية عن بكاء السماء.
مضافاً على أنّ خبر عمرو بن ثبيت يومئ إلى ذلك أيضاً.
ومنها: أنّها كناية عن شدّة غضب الباري (عزّ وجلّ) عمّا حصل من عِظم المصيبة، وفداحة الخطب، وعمق الجريمة، فالمقتول هو ابن بنت رسول الله، بطريقة مهولة يقشعر لها جبين الإنسانية، فلا عجب حينئذٍ أنْ تمطر السماء دماً؛ غضباً وسخطاً على هؤلاء القوم، وهذا ما أشارت إليه السيّدة زينب في خطبتها حين قالت: «أفعجبتم أنْ قطرت السماء دماً؟! ولعذاب الآخرة أخزى، فلا يَستخفنّكم المهل، فإنّه لا يحفزه البدار، ولا يخاف عليه فوت الثار، كلا إنّ ربّك لبالمرصاد...»[384].
كما أنّ لها دلالات عامّة كثيرة نشير إليها لاحقاً حين التكلّم عن دلالات جميع هذه الأحداث.
الفصل الثاني: الأخبار الدالّة على ظهور الدم تحت الأحجار
تخريج ودراسة الأخبار الدالّة على الحادثة من مصادر الشيعة
أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر
1 ـ الزهري.
2 ـ رجل من أهل بيت المقدس.
3 ـ أبو بصير.
4 ـ فاطمة بنت علي×.
5 ـ مرسلة عن الإمام الصادق×.
6 ـ مرسلة ابن شهر آشوب، عن أبي مخنف.
ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سنديّاً وفق مباني علماء الشيعة
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي الناقد بإسناده، قال: قال عمر بن سعد، قال: حدّثني أبو معشر، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين×، لم يبقَ في بيت المقدس حصاة إلّا وجد تحتها دم عبيط»[385].
وجاء في موضع آخر:
وقال عمر بن سعد: «وحدّثني أبو معشر، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين×، لم يبقَ في بيت المقدس حصاة إلّا وُجد تحتها دم عبيط»[386].
من الواضح أنّه قد مرّت ترجمة جميع رجال السند سابقاً، وتبيّن على ضوء ذلك أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة أبي معشر فقط، وهو يعدّ قرينة تتقوّى بها الأخبار الآتية، وقد تقدّم نقل كلام الزنجاني في اعتبار روايات أبي معشر هذا، وأنّه ليس نجيح بن عبد الرحمن، بل يوسف بن يزيد (أبو معشر البراء).
أضف إلى ذلك، فإنّ خبر الزهري ورد بطرق عديدة عند أهل السنّة على ما سيأتي، وأنّ بعض هذه الطرق صحيحة وفق مبانيهم، ممّا يؤكّد أنّ الخبر ثابت عن الزهري.
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي الناقد، قال: حدّثني عبد الرحمان الأسلمي، وقال لي أبو الحسين: وأخبرني عمّي، عن أبيه، عن أبي نصر، عن رجل من أهل بيت المقدس أنّه قال: والله، لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونواحيها عشية قَتل الحسين بن علي÷. قلت: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعنا حجراً، ولا مدراً، ولا صخراً، إلّا ورأينا تحتها دماً عبيطاً يغلي، واحمرّت الحيطان كالعلق، ومُطرنا ثلاثة أيام دماً عبيطاً، وسمعنا مناديا ينادي في جوف الليل يقول:
|
أتـرجـو أُمّـة قـتلت
حـسيناً |
|
شـفاعة جدّه يوم
الحساب |
|
مـعاذ الله لا
نُـلـتـم يـقـيـناً |
|
شفاعة أحـمد وأبـي
تراب |
|
قتلتم خير مَن ركب
المطايا |
|
وخير الشيب طُراً
والشباب |
وانكسفت الشمس ثلاثة أيام، ثمّ تجلّت عنها، وانشبكت النجوم، فلمّا كان من غد اُرجفنا بقتله، فلم يأتِ علينا كثير شيء حتى نعي إلينا الحسين×»[387].
تقدّمت دراسة هذا الخبر سابقاً، وتبيّن أنّ رجال هذا السند كلّهم من المجاهيل الذين لم يُترجم لهم سوى شيخ ابن قولويه، فهو ثقة بناءً على التوثيق العام الصادر من ابن قولويه، فلا يمكن تصحيح هذه الرواية إلّا بناءً على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، وقد تقدّم تراجع السيّد الخوئي عنه.
3 ـ خبر أبي بصير عن الإمام الباقر×
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبي&، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن يحيى بن بشير، قال: سمعت أبا بصير يقول: قال أبو عبد الله×: بعث هشام بن عبد الملك إلى أبي، فأشخصه إلى الشام، فلمّا دخل عليه، قال له: يا أبا جعفر، أشخصناك لنسألك عن مسألة لم يصلح أنْ يسألك عنها غيري، ولا أعلم في الأرض خلقا ينبغي أنْ يعرف أو عرف هذه المسألة إن كان إلّا واحداً، فقال أبي: ليسألني أمير المؤمنين عمّا أحبّ، فإن علمت أجبت ذلك، وإن لم أعلم قلت: لا أدري، وكان الصدق أولي بي.
فقال هشام: أخبرني عن الليلة التي قُتل فيها علي بن أبي طالب× بما استدلّ به الغائب عن المصر الذي قُتل فيه على قتله؟ وما العلامة فيه للناس؟ فإن علمت ذلك وأجبت فأخبرني هل كان تلك العلامة لغير على× في قتله؟ فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، إنّه لمّا كان تلك الليلة التي قُتل فيها أمير المؤمنين× لم يُرفع عن وجه الأرض حجر إلّا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها هارون أخو موسى÷، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها يوشع بن نون، وكذلك كانت الليلة التي رُفع فيها عيسى بن مريم إلى السماء، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها شمعون بن حمون الصفا، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها علي بن أبي طالب×، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها الحسين بن علي÷.
قال: فتربد وجه هشام حتى انتقع لونه، وهمّ أن يبطش بأبي، فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، الواجب على العباد الطاعة لإمامهم والصدق له بالنصيحة، وأن الذي دعاني إلى أن أجبت أمير المؤمنين فيما سألني عنه معرفتي إيّاه بما يجب له عليَّ من الطاعة، فليُحسن أمير المؤمنين عليّ الظنّ. فقال له هشام: انصرف إلى أهلك إذا شئت. قال: فخرج.
فقال له هشام عند خروجه: أعطني عهد الله وميثاقه أن لا توقع هذا الحديث إلى أحد حتّى أموت. فأعطاه أبي من ذلك ما أرضاه، وذكر الحديث بطوله»[388].
أورده القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بالإسناد إلى الشيخ الصدوق، «حدّثنا أحمد بن علي، عن أبيه، عن جدّه إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن علي بن عبد العزيز، عن يحيى بن بشير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله×، قال: سأل هشام بن عبد الملك أبي، فقال: أخبرني عن الليلة التي قُتل فيها علي بن أبي طالب بما استدلّ النائي عن المصر الذي قُتل فيه علي؟ وما كانت العلامة فيه للناس؟ وأخبرني هل كانت لغيره في قتله عبرة؟ فقال له أبي: إنّه لمّا كانت الليلة التي قُتل فيها علي (صلوات الله عليه) لم يُرفع عن وجه الأرض حجر إلّا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة التي فقد فيها هارون أخو موسى (صلوات الله عليهما)، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها يوشع بن نون، وكذلك كانت الليلة التي رُفع عيسى بن مريم (صلوات الله عليه)، وكذلك الليلة التي قُتل فيها الحسين (صلوات الله عليه)»[389].
الطريق الأوّل: وهو الذي رواه ابن قولويه: قال: «حدّثني أبي&، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن يحيى بن بشير، قال: سمعت أبا بصير يقول: ...» وذكره.
من الواضح وثاقة مشايخ ابن قولويه خصوصاً أنّه في المقام رواها بسند جمعي، فرواه عن أبيه وجماعة مشايخه، فلا أقل من وثاقة أحدهم حينئذٍ.
وسعد بن عبد الله الأشعري، وأحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن سعيد، كلّهم من الثقات الأجلّاء.
لكن الحسين بن سعيد روى الخبر عن رجل، والرجل رواها عن يحيى بن بشير، ويحيى مجهول أيضاً كما سيأتي.
تبيّن أنّ هذا الطريق ضعيف؛ لجهالة اثنين في السند.
نعم، في الطريق الثاني صرّح بأنّ الذي روى عن يحيى بن بشير هو علي بن عبد العزيز، وسيأتي ذكر ذلك عند دراسة الطريق الثاني.
الطريق الثاني: ما رواه القطب الراوندي، بالإسناد إلى الشيخ الصدوق، «حدّثنا أحمد بن علي، عن أبيه، عن جدّه إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن علي بن عبد العزيز، عن يحيى بن بشير، عن أبي بصير...».
أمّا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، فكما قال الوحيد: «يروى عنه الصدوق& مترضياً، ويُكثر من الرواية عنه، وفيهما إشعار بحسن الحالة والجلالة»[390].
وأبوه علي بن إبراهيم، من الثقات الأجلّاء. وأبوه إبراهيم بن هاشم، تقدّم القول بوثاقته.
وأمّا علي بن معبد، فقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي×، وقال: «بغدادي له كتاب»[391]، وكتابه هذا يرويه عنه إبراهيم بن هاشم كما في طريق الشيخ إليه[392]، وموسى بن جعفر كما في طريق النجاشي إليه[393]، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأورده الشيخ النمازي في مستدركاته، وذكر أنّ له: «جملة من الروايات تدلّ على حسن عقيدته وكماله»[394].
وعلي بن عبد العزيز، مشترك بين جماعة مجهولين جميعهم.
ويحيى بن بشير النبال: ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادق× من دون جرح ولا توثيق[395].
وأبو بصير: ثقة، فهو كما نصّ السيد الخوئي ينصرف عند الإطلاق إلى يحيى بن أبي القاسم[396]، وعلى تقدير الاغماض فالأمر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي، الثقة، فلا أثر للتردد، وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير، ويراد به غير هذين[397].
والنتيجة أنّ هذا السند ضعيف أيضاً.
اتّضح أنّ الطريق الأوّل والطريق الثاني كلاهما ضعيفان؛ لاتحادهما في جهالة يحيى بن بشير، وفي الراوي عنه، وهو رجل مبهم في الطريق الأوّل، وعلي بن عبد العزيز في الطريق الثاني.
أخرجه الشيخ الصدوق، قال: «حدّثني بذلك محمد بن علي ماجيلويه&، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن لوط بن يحيى، عن الحارث بن كعب، عن فاطمة بنت علي (صلوات الله عليهما): ثمّ إنّ يزيد (لعنه الله) أمر بنساء الحسين× فحبسن مع علي بن الحسين÷، في محبس لا يكنهم من حر ولا قر حتى تقشّرت وجوههم، ولم يرفع ببيت المقدس حجر عن وجه الأرض إلّا وجد تحته دم عبيط، وأبصر الناس الشمس على الحيطان حمراء كأنّها الملاحف المعصفرة[398]، إلى أن خرج علي بن الحسين÷ بالنسوة، وردَّ رأس الحسين× إلى كربلاء»[399].
أمّا ما جيلويه: فقد تقدّم سابقاً أنّه يمكن الاعتماد على روايته بقرائن عديدة.
ومحمد بن أبي القاسم: «ثقة»[400].
لكن محمد بن علي الكوفي، الظاهر هو الصيرفي أبو سمينة، بقرينة رواية محمد بن أبي القاسم عنه، وروايته بعنوان (أبي سمينة) عن نصر بن مزاحم، فقد ذكر النجاشي أنّ أحد طرق كتاب نصر بن مزاحم هي برواية أبي سمينة، فقال: «وأمّا طريقنا إليه من جهة القمّيين، فإنّه أخبرنا علي بن أحمد، قال: حدّثنا محمد بن الحسن، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن أبي علي البرقي، قال: حدّثنا أبو سمينة عنه بكتابه»[401].
وأبو سمينة هذا ضعيف جدّاً، مغالٍ كذّاب، قال النجاشي: «وكان محمد بن علي يُلّقب أبا سمينة، ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد، لا يُعتمد في شيء، وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب بالكوفة، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدّة، ثمّ تشهّر بالغلو فجفي، وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم، وله قصّة»[402].
ونصر بن مزاحم، تقدّم أنّه مستقيم الطريقة، ويمكن الركون إلى روايته.
ولوط بن يحيى، ثقة مسكون إلى روايته[403].
والحارث بن كعب، لم يذكروه، ولعلّه الحارث بن كعب الأزدي، الذي ذكره الشيخ في أصحاب الإمام السجاد×، لكنّه سكت عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً[404].
وبهذا يتّضح أنّ هذا السند ضعيف أيضاً.
رُوي عن الصادق×: «أنّ عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة ـ وفي رواية: هشام بن عبد الملك ـ أنْ وجّه إليّ محمد بن علي، فخرج أبي، وأخرجني معه، فمضينا حتّى أتينا مدين شعيب، فإذا نحن بدير عظيم [البنيان]، وعلى بابه أقوام عليهم ثياب صوف خشنة، فألبسني والدي، ولبس ثياباً خشنة، وأخذ بيدي حتّى جئنا وجلسنا عند القوم، فدخلنا مع القوم الدير، فرأينا شيخاً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فنظر إلينا، فقال لأبي: أنت منّا أم من هذه الأُمّة المرحومة؟ قال: لا، بل من هذه الأُمّة المرحومة. قال من علمائها أم من جهّالها؟ قال أبي: من علمائها. قال: أسألك عن مسألة؟ قال [له]: سل [ما شئت]. قال: أخبرني عن أهل الجنّة إذا دخلوها وأكلوا من نعيمها هل ينقص من ذلك شيء؟ قال: لا. قال الشيخ: ما نظيره؟ قال أبي: أليس التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يؤخذ منها ولا ينقص منها [شيء]؟ قال: أنت من علمائها. ثمّ قال: أهل الجنّة هل يحتاجون إلى البول والغائط؟ قال أبي: لا. قال [الشيخ]: وما نظير ذلك؟ قال أبي: أليس الجنين في بطن أُمّه يأكل ويشرب ولا يبول ولا يتغوط؟!
قال: صدقت. قال: وسأل عن مسائل [كثيرة] وأجاب أبي [عنها]، ثمّ قال الشيخ: أخبرني عن توأمين ولدا في ساعة، وماتا في ساعة، عاش أحدهما مائة وخمسين سنة، وعاش الآخر خمسين سنة، مَن كانا؟ وكيف قصتهما؟ قال أبي: هما عُزير وعزرة، أكرم الله تعالى عُزيرا بالنبوة عشرين سنة، وأماته مائة سنة، ثمّ أحياه فعاش بعده ثلاثين سنة، وماتا في ساعة [واحدة]. فخر الشيخ مغشيا عليه، فقام أبي، وخرجنا من الدير، فخرج إلينا جماعة من الدير، وقالوا: يدعوك شيخنا. فقال أبي: ما لي إلى شيخكم حاجة، فإن كان له عندنا حاجة فليقصدنا. فرجعوا، ثمّ جاؤوا به، وأُجلس بين يدي أبي، فقال [الشيخ]: ما اسمك؟ قال×: محمد. قال: أنت محمد النبي؟ قال: لا أنا ابن بنته. قال: ما اسم أُمّك؟ قال: أُمّي فاطمة. قال: مَن كان أبوك؟ قال: اسمه علي. قال: أنت ابن إليا بالعبرانية وعلي بالعربية؟ قال: نعم. قال: ابن شبّر أم شُبير؟ قال: إنّي ابن شُبير. قال الشيخ: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ جدّك محمداً رسول الله. ثمّ ارتحلنا حتى أتينا عبد الملك [ودخلنا عليه]، فنزل من سريره واستقبل أبي، وقال: عرضت لي مسألة لم يعرفها العلماء! فأخبرني إذ قَتلَتْ هذه الأُمّة إمامها المفروض طاعته عليهم، أيّ عبرة يريهم الله في ذلك اليوم؟ قال أبي: إذا كان كذلك لا يرفعون حجراً إلّا ويرون تحته دماً عبيطاً. فقبّل عبد الملك رأس أبي، وقال: صدقت، إنّ في اليوم الذي قُتل فيه أبوك علي بن أبي طالب× كان على باب أبي مروان حجر عظيم، فأمر أن يرفعوه، فرأينا تحته دماً عبيطاً يغلي. وكان لي أيضاً حوض كبير في بستاني، وكان حافتاه حجارة سوداء، فأمرت أن تُرفع ويُوضع مكانها حجارة بيض، وكان في ذلك اليوم قتل الحسين×، فرأيت دماً عبيطاً يغلي تحتها»[405].
وهذه الرواية مرسلة بلا سند، فهي ضعيفة أيضاً.
6 ـ مرسلة ابن شهر آشوب عن أبي مخنف
أوردها ابن شهر آشوب، حيث نقل عن أبي مخنف في رواية: «ولمّا قُتل الحسين صار الورس دماً، وانكسفت الشمس إلى ثلاثة أسباب، وما في الأرض حجر إلّا وتحته دم»[406].
وهذه الرواية محكومة بالضعف كسابقتها.
تخريج ودراسة الأخبار الدالة على الحادثة من مصادر أهل السنّة
أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر
1 ـ الزهري.
2 ـ أُمّ حبّان (حيّان).
3 ـ خلّاد عن أُمّه.
4 ـ ابن عباس.
5 ـ محمد بن عمر بن علي.
6 ـ يزيد بن أبي زياد.
7 ـ سعيد بن المسيّب.
ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سنديّاً وفق مباني أهل السنّة
تخريج الحديث من مصادر أهل السنّة
1 ـ خبر الزهري
ورد بطرق عديدة إلى الزهري:
الطريق الأوّل: ابن جريج عن الزهري
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا الضحّاك بن مخلّد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: ما رُفع بالشام حجر يوم قُتل الحسين بن علي إلّا عن دم (رضي الله عنه)»[407].
وأخرجه من طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وقال بعده: «رواه الهذيل عن الزهري مثله»[408].
وأخرجه أبو العرب، قال: «حدّثني عمر بن يوسف، قال: حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدّثني أبو عاصم، عن ابن جريح[409]، عن ابن شهاب، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي، لم يُرفع حجر بالشام إلّا وجد تحته دم»[410].
وأخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزّار (شيخ الحنفية بنيسابور)[411] في كتاب الفتن، على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: ما قُلب حجر بالشام يوم قُتل الحسين إلّا عن دم»[412].
وأخرجه البلاذري، قال: «وحدّثنا [أي: عمر بن شبّة]، عن أبي عاصم النبيل، عن أبي جريج (كذا)، عن ابن شهاب، قال: ما رُفع حجر بالشام يوم قُتل الحسين إلّا عن دم»[413].
وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي، قال: «حدّثنا أبو أحمد، قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدّثنا [أبو عاصم] النبيل، قال: حدّثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي، لم يُرفع في الشام حجر إلّا وجد تحته دم عبيط»[414].
الطريق الثاني: محمد بن عبد الله بن سعيد العاص عن الزهري
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنا هشيم، ثنا أبو معشر، عن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص، عن الزهري، قال: قال لي عبد الملك بن مروان: أيّ واحد أنت إنْ أخبرتني، أيُّ علامة كانت يوم قُتل الحسين بن علي؟ قال: قلت: لم تُرفع حصاة ببيت المقدس إلّا وُجد تحتها دم عبيط. فقال عبد الملك: إنّي وإيّاك في هذا الحديث لقرينان»[415].
ومن طريقه أخرجه الكنجي الشافعي[416].
الطريق الثالث: أبو بكر الهذلي عن الزهري
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يزيد بن مهران أبو خالد، ثنا أسباط بن محمد، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنه)، لم يُرفع حجر ببيت المقدس إلّا وجد دم عبيط»[417].
وأخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزار (شيخ الحنفية بنيسابور)[418] في كتاب الفتن على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا علي بن سلمة، قال: حدّثنا أسباط، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي، لم تُقلب ببيت المقدس حصاة إلّا وجد تحتها دم عبيط»[419].
وأخرجه الحلبي بسنده إلى عبيد الله بن محمد الفريابي، قال: «حدّثنا محمد بن شعيب السنجي، عن عيسى بن يونس، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما) لم تُرفع ببيت المقدس حصاة إلّا وجد تحتها دم عبيط»[420].
الطريق الرابع: مَعْمَر عن الزهري
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري، أنّه كان في مجلس عبد الملك بن مروان، فسألهم عبد الملك، فقال: مَن منكم يعلم ما صنعت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين؟ قال: فلم يكن عند أحد منهم من ذلك علم، فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب منه يومئذٍ حجر إلّا وجد تحته دم عبيط. قال: فعُرف من يومئذٍ» [421].
وأخرجه البيهقي، قال: «أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك. فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب حجر إلّا وُجد تحته دم عبيط»[422].
ومن طريق عبد الله بن جعفر أخرجه الحلبي ابن أبي جرادة، قال: «نبأنا عمر بن محمد المؤدب، قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد إجازة إنْ لم يكن سماعاً، قال: أخبرنا محمد بن هبة الله، قال أخبرنا محمد بن الحسين، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدّثنا يعقوب ـ يعني ابن سفيان ـ قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عرف الزهري تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك. فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: بلغني أنّه لم تُقلب حجر إلّا وجد تحته دم عبيط»[423].
ومن طريق البيهقي وغيره أخرجه ابن عساكر بسنده إلى يعقوب بن سفيان: «أنبأنا سليمان بن حرب، أنبأنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري، [أنّه] تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك. فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري ـ زاد عبد الكريم وابن السمرقندي: بلغني. وقالوا:ـ إنّه لم يُقلب حجر إلّا ـ زاد ابن السمرقندي: وُجد تحته. وقال البيهقي: إلّا ـ وتحته دم عبيط»[424].
وأخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزار (شيخ الحنفية بنيسابور)[425] في كتاب الفتن على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا أحمد بن سعيد، قال: حدّثنا سليمان، قال: حدّثنا حمّاد، عن مَعْمَر، قال: إنّ أوّل ما عُرف الزهري، أنّه كان عند عبد الملك بن مروان، فسأل جلساءه: مَن منكم مَن يعلم ما صنعت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين؟ فلم يكن عند أحد منه علم، فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب يومئذٍ منها حجر إلّا وجدوا تحت دماً عبيطاً»[426].
وأورده المزي، قال: قال يعقوب بن سفيان: «حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري، تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك، فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب حجر إلّا وُجد تحته دم عبيط»[427].
وأورده الذهبي في السيّر: «حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري، أنّه تكلّم في مجلس الوليد، فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين؟ فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب حجر إلّا وُجد تحته دم عبيط»[428].
وأخرجه الخوارزمي، لكنّه أسقط اسم مَعْمَر، ونسب الرواية إلى حمّاد بن زيد[429].
الطريق الخامس: رجل من آل سعيد عن الزهري
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثني نجيح، عن رجل من آل سعيد، يقول: سمعت الزهري يقول: سألني عبد الملك بن مروان، فقال: ما كان علامة مقتل الحسين؟ قال: لم تكشف يومئذٍ حجراً إلّا وجدت تحته دماً عبيطاً. فقال عبد الملك: أنا وأنت في هذا غريبان»[430].
أخرجه أبو العرب، قال: «وحدّثني بكر بن حمّاد، قال: حدّثني إبراهيم بن سليمان الرملي، قال: حدّثني سعيد بن كثير بن غفير، عن يحيى بن وشاح، عن البصـري بن يحيى، عن الزهري، قال: دخلت على عبد الملك بن مروان وهو في القبة، فقال لي: استدر من وراء السجف، فاستدرت، فقال: أتدري ما حدث في الأرض يوم قُتل الحسين؟ قلت: نعم. قال: لم يُقلب حجر ولم يُكشف إناء ببيت المقدس إلّا أصابوا تحته دماً عبيطاً. فقال لي: إنّي وإيّاك غريبان في هذا الحديث، فإيّاك أنْ أسمعه من أحد»[431].
الطريق السابع: عمرو بن قيس وعقيل عن الزهري
أخرجه ابن عبد ربّه الأندلسي، قال: «حدّثنا أبو محمد عبد الله بن ميسرة، قال: حدّثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى الجهني، عن عمر بن قيس.
وقال حمّاد بن عيسى: حدّثني به عبّاد بن بشر، عن عقيل، قالا: قال الزهري: خرجت مع قتيبة أُريد المصيصة، فقدمنا على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وإذا هو قاعد في إيوان له، وإذا سماطان من الناس على باب الإيوان، فإذا أراد حاجة قالها للذي يليه حتّى تبلغ المسألة باب الإيوان، ولا يمشي أحد بين السماطين. قال الزهري: فجئنا فقمنا على باب الإيوان، فقال عبد الملك للذي عن يمينه: هل بلغكم أيّ شيء أصبح في بيت المقدس ليلة قُتل الحسين بن علي؟ قال: فسأل كلّ واحد منهما صاحبه حتى بلغت المسألة الباب، فلم يرد أحد فيها شيئاً، قال الزهري فقلت: عندي في هذا علم. قال: فرجعت المسألة رجلاً عن رجل حتى انتهت إلى عبد الملك، قال: فدُعيت، فمشيت بين السماطين فلمّا انتهيت إلى عبد الملك سلّمت عليه، فقال لي: مَن أنت؟ قلت: أنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، قال: فعرفني بالنسب، وكان عبد الملك طلّابه للحديث، فقال: ما أصبح ببيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي بن أبي طالب ـ وفي رواية علي بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبي معشر، عن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن العاص، عن الزهري أنّه قال: الليلة التي قُتل في صبيحتها الحسين بن علي؟ ـ قال الزهري: نعم، حدّثني فلان ـ لم يسمّه لنا ـ أنّه لم يُرفع تلك الليلة التي صبيحتها قُتل الحسين بن علي حجر في بيت المقدس إلّا وُجد تحته دم عبيط. قال عبد الملك: صدقت، حدّثني الذي حدّثك، وإنّي وإيّاك في هذا الحديث لغريبان. ثمّ قال لي: ما جاء بك؟ قلت: مرابطاً. قال: الزم الباب. فأقمت عنده، فأعطاني مالاً كثيراً»[432].
من الواضح أنّ الطرق إلى الزهري عديدة توجب الاطمئنان بثبوت الخبر عنه، خصوصاً أنّ بعضها صحيحة أو حسنة من حيث السند؛ لذا لا نرى مبرراً للخوض تفصيلاً في دراسة هذه الأسانيد، بل سنمرُّ على بعضها مروراً سريعاً؛ ليتبينّ أنّ الحديث ثابت للزهري من دون أيّ كلام، وحينئذٍ نقول:
الطريق الأوّل:
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا الضحّاك بن مُخلّد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: ما رُفع بالشام حجر يوم قُتل الحسين بن علي إلّا عن دم (رضي الله عنه)»[433].
وأخرجه آخرون بطرق أُخرى كلّها تدور على ابن جريج، عن الزهري.
وهذا الطريق صحيح سنداً؛ فزكريا الساجي من الأئمّة الثقات المعروفين، ومحمد بن المثنى، ثقة ثبت ورع[434]، والضحّاك بن مُخلّد أبو عاصم النبيل، ثقة ثبت[435]، وابن جريج، إمام، ثقة، معروف[436]، ومحمد بن مسلم الزهري من الأئمّة الثقات.
فرجال هذا السند كلّهم ثقات، وقد قال فيه الهيثمي: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح»[437].
الطريق الثاني:
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنا هشيم، ثنا أبو معشر، عن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص، عن الزهري...».
وهذا الطريق رجاله ثقات كما صرّح الهيثمي بذلك، قال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات»[438].
الطريق الثالث:
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يزيد بن مهران أبو خالد، ثنا أسباط بن محمد، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري...».
ورجال السند ثقات على كلام في الهذلي، فمحمد بن عبد الله الحضرمي، ثقة حافظ[439]، ويزيد بن مهران، ثقة[440]، وإسباط بن محمد، ثقة[441]، وذكر ابن حجر أنّه ضُعّف في خصوص الثوري[442]، وفي المقام لم يروِ عن الثوري.
وممّا يزيد الطريق قوة أنّ الحلبي كما تقدّم قد أخرجه من وجه آخر إلى الهذلي[443].
وأمّا أبو بكر الهذلي، ففيه كلام، وقد سبر رواياته ابن عدي وخلُص إلى أنّ له أحاديث صالحة، وأنّ عامّة ما يُحدّث به قد شُورك به، وحديثه محتمل، وفي حديثه ما لا يُحتمل ولا يتابع عليه[444].
وفي الخبر ـ محلّ البحث ـ فإنّ الهذلي لم ينفرد عن الزهري، بل تابعه عليه ستّة من الرواة كما ظهر من التخريج، فيكون الخبر مقبولاً.
الطريق الرابع:
وهو ما أخرجه ابن سعد، والبيهقي، وغيرهما، والذي مداره سليمان بن حرب، قال: «حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر...».
ومن الواضح أنّ رواة هذا الخبر كلّهم من الثقات، فسليمان بن حرب من الأئمّة الثقات، وحمّاد بن زيد كذلك، وأمّا مَعْمَر، فإنّه وإنْ كان ثقة إلّا أنّ فيه بعض الكلام، فقد قال الذهبي: «أحد الأعلام الثقات، له أوهام معروفة، احتملت له في سعة ما أتقن. قال أبو حاتم: صالح الحديث، وما حدّث به بالبصرة، ففيه أغاليط»[445].
وقال ابن حجر: «ثقة ثبت فاضل، إلّا أنّ في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدّث به بالبصرة»[446].
فتحصّل أنّ هذا الخبر رواته ثقات أيضاً على بعض الكلام في مَعْمَر.
الطريق الخامس:
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثني نجيح، عن رجل من آل سعيد، يقول: سمعت الزهري يقول: ...».
وهذه الرواية ضعيفة؛ لجهالة الرجل الذي سمع الزهري، وكذلك فإنّ هناك كلام كثير في محمد بن عمر الواقدي[447]، وكلام في نجيح أبو معشر أيضاً، لكن ذلك لا يمنع من الاعتماد على الخبر لطرقه العديدة التي تقدّمت.
الطريق السادس:
أخرجه أبو العرب في المحن، قال: «وحدّثني بكر بن حمّاد، قال: حدّثني إبراهيم بن سليمان الرملي، قال: حدّثني سعيد بن كثير بن غفير، عن يحيى بن وشاح، عن البصري بن يحيى، عن الزهري...»
وهذا الخبر فيه ضعف من جهة يحيى بن وشاح، والبصري بن يحيى؛ إذ لم أقف على ترجمة لهما.
الطريق السابع:
أخرجه ابن عبد ربّه الأندلسي، قال: «حدّثنا أبو محمد عبد الله بن ميسرة، قال: حدّثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى الجهني، عن عمر بن قيس.
وقال حمّاد بن عيسى: حدّثني به عبّاد بن بشر، عن عقيل، قالا: قال الزهري: ...».
أمّا ابن عبد ربّه، فهو ثقة، قال فيه الذهبي: «العلّامة الأديب الأخباري، صاحب (كتاب العقد)... وكان موثّقاً نبيلاً، بليغاً شاعراً»[448].
وعبد الله بن ميسرة[449]، فهو ثقة، قال فيه الذهبي: «كان من علماء أهل قرطبة... وكان جليلاً فاضلاً خيّراً، ولكنّه اتُّهم بالقدر»[450].
ومحمد بن موسى الحرشي: إنْ كان هو البصري كما هو الأوفق بحسب الطبقات، فقد ضعّفه ابن داوُد وقوّاه غيره[451]. وقال عنه الذهبي: «صدوق»[452].
وإنْ كان هو الملقّب بشاباص الذي يروي عن خليفة بن خياط وطبقته، فهو ثقة[453]، لكنّ الأوفق كما قلنا أنْ يكون المراد به الأوّل دون الثاني، وإنْ كان احتمال الثاني ممكن في حدّ ذاته؛ فإنّ وفاة خليفة بن خياط في سنة (240هـ)، فالمناسب أنْ يكون الراوي عنه من طبقة عبد الله بن مسرة لا من طبقة تلاميذه.
وأمّا حمّاد بن عيسى الجهني، فهو من الثقات عند الشيعة الإمامية[454]، لكنّه محلّ كلام عند أهل السنّة، قال ابن معين: «شيخ صالح»[455]. وضعّفه جماعة غيره. قال الذهبي: «ضعّفه أبو داوُد، وأبو حاتم، والدارقطني، ولم يتركه»[456]. ولا يبعد أنْ يكون للانتماء المذهبي تأثير في ذلك.
وعلى كلّ حال، فقد حكموا على الرجل بالضعف، لكنّ حديثه يصلح أنْ يكون حسناً في المتابعات والشواهد.
أمّا عمر بن قيس، فهو مشترك في ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة كلّهم رووا عن الزهري، وبعد طول بحث وتحقيق لم أتمكّن من تشخيص المراد في الخبر أعلاه، وهؤلاء الثلاثة هم: قيس بن عمر الماصر، وعمر بن قيس أبو حفص المكي، وعمر بن قيس الأنصاري.
أمّا قيس بن عمر الماصر، فقد روى عن الزهري كما في معجم الطبـراني[457]، وهو ثقة كما نصّ عليه غير واحد[458].
وأمّا عمر بن قيس الكوفي المعروف بسندل، فقد روى عدّة روايات عن الزهري، وهو ضعيف، بل متروك كما هو واضح من ترجمته[459].
وأمّا عمر بن قيس الأنصاري، فهو مجهول[460].
فهذا الطريق إلى الزهري مضافاً لضعف حمّاد، ففيه عمر بن قيس، وهو مشترك بين ثقة، ومتروك، ومجهول.
وأمّا الطريق الثاني الذي ذكره ابن عبد ربّه عن حمّاد بن عيسى، فهو عن عبّاد بن بشر، عن عقيل.
وعبّاد بن بشر، وعقيل لم أقف عليهم.
فتحصّل أنّ هذا الطريق ضعيف أيضاً.
1 ـ تبيّن أنّ الرواية ثابتة للزهري؛ لكثرة الطرق المروية عنه، وبعض هذه الطرق رجالها ثقات، وبعضها وإنْ كان فيها ضعف إلّا أنّها تصلح للمتابعة والمعاضدة.
2 ـ إنّ هناك اختلافاً في النقل، فبعض الأخبار ذكرت أنّ القول للزهري وذكرته بصيغة الجزم والقطع، وبعضها جاء بلفظ بلغني، أو حدّثني فلان ولم يسمّه، مما يعني ضعف الخبر؛ لجهالة الراوي الذي روى عنه الزهري.
لكن التحقيق يقتضي أنّ الخبر الوارد بنحو الجزم مقدّم على غيره؛ ذلك لكثرة طرقه وصحّة بعضها، فمن مجموع سبعة طرق يوجد خمسة طرق ذكرت الخبر بنحو الجزم، وأمّا التي وردت بصيغة بلغني فهما خبران أحدهما صحيح والآخر ضعيف، وهو الذي ورد عن ابن عبد ربّه الأندلسي.
3 ـ لو فرضنا جدلاً أنّ الخبر الصحيح والمقدّم هو بلفظ بلغني، فحينئذٍ يكون خبر الزهري ضعيف ويحتاج إلى عاضد يعضده، والعاضد والشاهد موجود كما سيأتي، فيرتفع الخبر بالمجموع إلى الحسن أو الصحيح لغيره.
4 ـ نلاحظ أنّ عبد الملك بن مروان، وهو خليفة أُموي يصرُّ ويجتهد في السؤال عن العلامة التي حصلت يوم عاشوراء، ممّا يعني أنّه كان يعلم بوقوع الحادثة، ويحتاج إلى مَن يُصرّح بها؛ ليتأكّد أكثر ويطمئن بحصول ذلك والله أعلم. ولربما يومئ إلى ذلك قوله للزهري: «إنّي وإيّاك في هذا الحديث لقرينان». وفي بعض الأخبار: «لغريبان» كما تقدّم.
5 ـ إنّ بعض العلماء صرّح بصحة خبر الزهري كالهيثمي، وقد أوردنا قوله سابقاً، وكذلك البيهقي، حيث علّق على ما ورد من أنّ تلك الحادثة حصلت حين قُتل الإمام علي، قائلاً: «ورُوِي بإسناد أصحّ من هذا، عن الزهري: أنّ ذلك كان من قَتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما)»[461].
وفي لفظ ابن حجر: «والذي صحّ عنه أنّ ذلك حين قُتل الحسين، ولعلّه وُجد عند قتلهما جميعاً»[462].
وفي لفظ الزرندي الحنفي: «وقد رُوي بإسناد صحيح عن الزهري أنّ ذلك كان حين قُتل الحسين بن علي×، ولعلّه وُجد عند قتلهما جميعاً والله أعلم»[463].
2 ـ رواية أُمّ حبّان أو (حيّان)
أخرجها ابن عساكر من طريق البيهقي، والخطيب، وابن هبة الله، قالوا: «أنا محمد بن الحسين، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، حدّثني أيوب بن محمد الرقي، نا سلام بن سليمان الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حدّثتني أُمّ حيّان، قالت: يوم قُتل الحسين أظلمت علينا ثلاثاً ولم يَمسّ أحد من زعفرانهم شيئاً فجعله على وجهه إلّا احترق، ولم يُقلب حجر ببيت المقدس إلّا أ صبح تحته دم عبيط»[464].
ومضافاً لرواية ابن عساكر من طريق البيهقي، فقد عزّاها السيوطي إلى البيهقي أيضاً[465]، لكنّنا مع التتبع لم نعثر على هذا الخبر في كتاب الدلائل المطبوع!
وأخرجها الحلبي، قال: «أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي ـ فيما أذن لي في روايته ـ قال: أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المشرف بن المسلم بن مسلم بن حميد الأنماطي إجازةً، قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن حمود الصواف، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الواسطي، قال: حدّثنا أبو حفص عمر بن الفضل بن المهاجر الربعي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا الوليد الرملي، قال: حدّثنا أبو نصر محمد، قال: حدّثنا سلام بن سليمان الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حدّثتني أُمّ حبّان، قالت يوم قُتل الحسين (رضي الله عنه) أظلمت علينا ثلاثاً، ولم يَمسّ أحد من زعفرانهم شيئاً إلّا احترق، ولم يُقلب حجر ببيت المقدّس إلّا أصبح عنده دماً عبيطاً»[466].
وأوردها المزي عن يعقوب بن سفيان، قال: «وقال يعقوب بن سفيان الفارسي: حدّثني أيوب بن محمد الرقي، قال: حدّثنا سلام بن سليمان الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حدّثتني أُمّ حيّان، قالت: يوم قُتل الحسين أظلمّت علينا ثلاثاً، ولم يَمسّ أحد من زعفرانهم شيئاً، فجعله على وجهه إلّا احترق، ولم يقلب حجراً ببيت المقدس إلّا أُصيب تحته دم عبيط»[467].
وأخرجها الخوارزمي من طريق البيهقي أيضاً، لكنّه ذكر أنّ الراوي المباشر هو: أُمّ حسّان[468]، والظاهر أنّه تصحيف.
دراسة سندية لخبر أُمّ حبّان (حيّان)
من الواضح أنّ أقصر سند لهذا الخبر هو ما أخرجه يعقوب بن سفيان: «حدّثني أيوب بن محمد الرقي، قال: حدّثنا سلام بن سليمان الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حدّثتني أُمّ حيّان...» وذكر الخبر.
أمّا يعقوب بن سفيان، فمن الأئمّة الثقات المعروفين، وأيوب بن محمد الرقي، أبو محمد مولى ابن عباس، فمن الثقات[469]، قال فيه ابن حجر: «ثقة»[470]. وقال الذهبي: «حجّة»[471].
وأمّا سلام بن سليمان بن سوار الثقفي، فمختلف فيه، قال فيه النسائي: «ثقة مدائني»[472]. وقال فيه أبو حاتم: «ليس بالقوي»[473]. ومن المعروف في مصطلح الحديث أنّ المراد من قولهم (ليس بالقوي) هو نوع من التعديل؛ بحيث يكون حديثه حسناً لا ضعيفاً، ووثّقه الحاكم في المستدرك[474]، وصحّح له في موضع آخر[475].
وفي مقابل ذلك، فهناك مَنْ يرى أنّ في أحاديثه مناكير، وأنّه غير متابع على ما يرويه[476].
ومع ملاحظة أنّ النسائي، وأبا حاتم من المتشددين في التوثيق، وأنّ وجود النكارة في بعض أحاديثه لا ينافي الوثاقة، فيمكن القول بحسن أحاديث الرجل؛ ولذا نرى ابن عدي يُصرّح بعد أنْ يذكر له مجموعة من الأحاديث بأنّ سائر أحاديثه حسان، قال: «ولسلام غير ما ذكرت وعامّة ما يرويه حسان إلّا أنّه لا يُتابع عليه»[477]. فمن الواضح أنّ ابن عدي لم يجد ما يخلّ بروايات سلام هذا، غير التفرّد وعدم متابعة غيره له، وعدم المتابعة لوحدها غير قادحة مع تصريح النسائي بوثاقته، وتصريح أبي حاتم ـ وهو من تلاميذ سلام هذا ـ بأنّه ليس بالقوي، أي: ليس من الحفّاظ الأثبات كما هو معلوم في تفسير هذه العبارة[478]؛ ولذا نرى أنّ حديثه لا يقلّ عن درجة الحسن، خصوصاً أنّه لم ينفرد بهذا الخبر، بل للخبر طرق عدّة كما تقدّم.
وأمّا زيد بن عمرو الكندي، فلم نقف على ترجمة له، نعم عثرنا على شخص باسم زيد بن عمير الكندي وهو من الصحابة[479]، لكن حينئذٍ يتعيّن سقوط واسطة بينه وبين سلام بن سليمان الثقفي؛ لأنّ وفاته سنة (210هـ) ولا يمكن أنْ يروي عن الصحابة.
وبعد طول مراجعة وقفنا على راوٍ باسم زيد أبو عمرو، وليس ابن عمرو، وهذا الراوي يروي عن أُمّ حيّان كما هو الحال في هذه الرواية، فلعلّ هناك تصحيفاً وقع في اسم الراوي، والصحيح هو زيد أبو عمرو.
وزيد أبو عمرو هذا ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «زيد أبو عمرو يروى عن أُمّ حيّان، روى عنه فضيل بن منبوذ»[480]. وذكره كذلك البخاري في تاريخه[481]. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل[482]. ولم يذكرا له جرحاً أو تعديلاً، وقد تقدّم سابقاً أنّ سكوت البخاري والرازي عن الراوي يُعدّ توثيقاً له عند جملة من العلماء.
وأمّا أُمّ حبّان (حيّان)، فإنْ كان الراوي عنها هو أبو عمرو كما أوضحنا فهي الهمدانية، ولم نقف لها على ترجمة، وإنْ كان الراوي عنها هو زيد بن عمرو ـ ولم نقل إنّ هناك تصحيفاً في اسم الراوي ـ فتكون أُمّ حيّان مشتركة، فقد تكون الهمدانية المشار إليها، وقد تكون الصحابية أُمّ حبّان بنت عامر، وقد تكون غيرهما والله العالم.
خلاصة الحكم على خبر أُمّ حيّان
تبيّن أنّ الخبر بهذا السند لا يخلو من ضعف إمّا من جهة زيد بن عمرو، أو من جهة أُم حيّان، لكنّ هذا الضعف ليس ضعفاً شديداً، بل هو منجبر بورود الخبر من طرق أُخرى، فتتقوّى مع بعضها.
هذا، وقد أشرنا سابقاً أنّ ابن عساكر والسيوطي نسبوا تخريج الرواية إلى البيهقي، وعرفنا فيما تقدّم أنّ البيهقي إذا خرّج حديثاً وسكت عنه، فهو صحيح معتبر عنده، وهذا ما يقوّي صحة الطريق أعلاه، وصحة أصل الخبر، خصوصاً أنّ البيهقي صرّح بصحة طريق الزهري كما ذكرنا عبارته هناك.
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدّثنا خلّاد ـ صاحب السمسم، وكان ينزل بني جحدر ـ قال: حدّثتني أُمّي، قالت: كنّا زماناً بعد مقتل الحسين، وأنّ الشمس تطلع مُحمرّة على الحيطان والجدران بالغداة والعشي، قالت: وكانوا لا يرفعون حجراً إلّا وجدوا تحته دماً»[483].
وأخرجه ابن عساكر من طريق عمرو بن عاصم الكلبي، عن خلّاد، عن أُمّه، بلفظ يقرب من ذلك[484].
دراسة سندية لخبر خلّاد عن أُمّه
الخبر كما عرفنا أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال حدّثنا خلاد ـ صاحب السمسم، وكان ينزل بني جحدر ـ قال: حدّثتني أُمّي...» وذكره.
أمّا عمرو بن عاصم الكلابي، فمن رجال البخاري ومسلم والأربعة، وأحد الحفّاظ المعروفين، وفيه كلام قليل لا ينزله عن مرتبة الاحتجاج، وحديثه يدور بين الصحة والحسن؛ ولذا وثّقه الذهبي، فقال فيه تارةً: «ثقة معروف»[485]، وقال عنه تارةً أُخرى: «الحافظ الثبت»[486]. وقال فيه ابن حجر: «صدوق في حفظه شيء»[487].
وأمّا خلّاد صاحب السمسم، فلم أقف له على ترجمة.
وأُمّه كذلك لم أقف لها على ترجمة.
والخلاصة: إنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة خلّاد وأُمّه، والجهالة لا تمنع من كون الخبر صالحاً للمعاضدة مع غيره من الأخبار.
أورده مُرسلاً القندوزي الحنفي، قال: «وعن ابن عباس: إنّ يوم قُتل الحسين× قطرت السماء دماً، وإنّ هذه الحمرة التي تُرى في السماء ظهرت يوم قتله، ولم تُرَ قبله، وإنّ أيام قتله لم يُرفع حجر في الدنيا إلّا وجد تحته دم»[488].
وهذا الخبر لم نقف له على إسناد معيّن حتى نقوم بدراسته؛ فهو ضعيف بالإرسال.
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثني عمر بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، قال: أرسل عبد الملك إلى ابن رأس الجالوت، فقال: هل كان في قتل الحسين علامة؟ فقال ابن رأس الجالوت: ما كُشف يومئذٍ حجر إلّا وجد تحته دم عبيط»[489].
ومن طريقه أخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو بكر الشاهد، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو عمر الخزاز، أنا أبو الحسن الخشاب بن الفهم، أنا محمد بن سعد، أنا محمد بن عمر، حدّثني عمر بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، قال: أرسل عبد الملك إلى ابن رأس الجالوت، فقال: هل كان في قتل الحسين علامة؟ قال ابن رأس الجالوت: ما كُشف يومئذٍ حجر إلّا وجد تحته دم عبيط»[490].
وأخرجه الكنجي الشافعي أيضاً[491].
أمّا محمد بن عمر الواقدي، ففيه كلام طويل جدّاً؛ إذ وثّقه جملة كبيرة من العلماء، وضعّفه غيرهم، وقد نقل الخطيب الكثير من الكلمات المختلفة فيه، منها:
قال إبراهيم الحربي: «الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام».
وقال أبو بكر الصغاني: «لقد كان الواقدي وكان، وذكر من فضله، وما يحضر مجلسه من الناس من أصحاب الحديث، مثل: الشاذكوني، وغيره، وحسّن أحاديثه، ثمّ قال أبو بكر: أمّا أنا فلا أحتشم أن أروى عنه».
وقال الذهلي: «ثقة».
وقال عمر الناقد: «قلت للدراوردي: ما تقول في الواقدي؟ قال: تسألني عن الواقدي! سل الواقدي عنّي... ذاك أمير المؤمنين في الحديث».
وقال الدراوردي أيضاً: قال أبو عامر العقدي: «نحن نُسأل عن الواقدي! إنّما يُسأل الواقدي عنّا، ما كان يفيدنا الشيوخ والأحاديث بالمدينة إلّا الواقدي».
وقال مصعب الزبيري: «والله ما رأينا مثله قطُّ».
وقال أيضاً: «ثقة مأمون».
وسُئل المسيبي عنه، فقال: «ثقة مأمون».
وسُئل معن بن عيسى عنه، فقال: «أُسأل أنا عن الواقدي! يُسأل الواقدي عنّي».
وسُئل عنه أبو يحيى الزهري، فقال: «ثقة مأمون».
وقال يزيد بن هارون: «محمد بن عمر الواقدي ثقة».
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «الواقدي ثقة».
وفي قبال هذه التوثيقات الصريحة توجد عدّة من التضعيفات الصريحة أيضاً، بل بعضهم اتّهمه بالكذب والوضع، ومن جملة مَن ضعّفه أو كذّبه: الشافعي، وابن معين، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو زرعة، وغيرهم[492].
من هنا وقع الاضطراب في أمره، وتحقيق الحال فيه يحتاج إلى رسالة مفصّلة، إلّا أنّ هناك جملة من العلماء انتهوا إلى صدق الرجل وحسن حديثه، فهذا ابن كثير المحدّث والمؤرّخ المعروف، قال عنه: «والواقدي (رح) عنده زيادات حسنة، وتاريخ محرر غالباً، فإنّه من أئمّة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه، مكثار، كما بسطنا القول في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، ولله الحمد والمنّة»[493].
وقال التهانوي: «فإنّ الصحيح في الواقدي التوثيق»[494]. وذكر بعد ذلك قول الشيخ تقي الدين ابن العيد، في أنّ شيخه ابن سيّد الناس قد جمع الأقوال في جرحه وتوثيقه، ورجّح توثيقه، وذكر الأجوبة عمّا قيل فيه[495].
وقال ابن الهمام الحنفي: «وهو حسن عندنا»[496].
والخلاصة: إنّه يمكن الاعتماد على رواية وخبر الواقدي، خصوصاً أنّه في قضية تاريخية وليس في حديث نبوي؛ لذا فإنّ ياقوت الحموي بعد أنّ ذكر التوثيقات في الرجل، قال: «وهو مع ذلك ضعّفه طائفة من المحدّثين كابن معين، وأبي حاتم، والنسائي، وابن عدي، وابن راهويه، والدارقطني. أمّا في أخبار الناس والسير، والفقه وسائر الفنون، فهو ثقة بإجماع»[497].
أمّا عمر بن محمد بن عمر بن علي، فمجهول الحال.
وأبوه محمد بن عمر بن علي، فذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «يروى عن علي بن أبي طالب، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، والثوري»[498]. وقال الذهبي: «ثقة»[499]. وقال ابن حجر: «صدوق»[500].
تبيّن أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة عمر بن محمد، لكنّه يصلح في المتابعات والشواهد، ويتعاضد مع بقيّة الطرق.
لكن قد يُقال: إنّ هناك مشكلة أُخرى في الخبر، وهي أنّ محمد بن علي لم يروِ الحادثة، بل شاهد سؤال عبد الملك لابن رأس الجالوت، وابن رأس الجالوت أجابه بذلك، وابن رأس الجالوت من اليهود، فكيف نعتمد على اليهود في هذه الأخبار.
والجواب:
1 ـ إنّه كما أشرنا سابقاً أنّ عبد الملك كان بحسب الظاهر يصرّ على السؤال، وهذا يكشف أنّه كان يعلم بالحادثة، ويريد الاستفسار من جهات مختلفة؛ ليطمئن أكثر.
2 ـ إنّ تصريح ابن رأس الجالوت بوقوع الحادثة، يكشف عن أنّ الحادثة معروفة؛ بحيث أقرّ بحدوثها حتى اليهود وكبرائهم.
3 ـ إنّ القضيّة تتعلّق بالتأريخ، وربّما كان علماء اليهود عندهم اطلاع أكثر من غيرهم على ذلك؛ لذا عمد عبد الملك وسأل ابن رأس الجالوت عمّا حصل في ذلك اليوم.
4 ـ إنّ الاعتماد هنا ليس على خبر رأس الجالوت منفرداً حتّى يقال إنّه اعتماد على اليهود، بل هو أحد الشواهد على حصول الحادثة، على أنّ هناك روايات صحيحة عند أهل السنّة حول جواز التحديث عن بني إسرائيل، فقد جاء في صحيح البخاري: «وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»[501].
روى أبو الشيخ في كتاب (السنّة) كما نقله الزرندي في نظم درر السمطين، بسنده إلى يزيد بن أبي زياد، قال: «شهدت مقتل الحسين، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فصار الورس في عسكرهم رماداً، واحمرّت السماء لقتله، وانكسفت الشمس لقتله حتى بدت الكواكب نصف النهار، وظنّ الناس أنّ القيامة قد قامت، ولم يُرفع حجر في الشام إلّا رؤى تحته دم عبيط»[502].
لكن من المؤسف أنّ كتاب السنّة لأبي الشيخ لم يصل إلينا، فلم نقف على سنده، فيكون الخبر مرسلاً.
أخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزار (شيخ الحنفية بنيسابور)[503] في كتاب الفتن على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا علي بن الحسن، قال: حدّثنا محمد بن القاسم، قال: حدّثنا هشام بن سعد، عمّن حدّثه، عن سعيد بن المسيب: أنّ عبد الملك بن مروان كتب إليه: هل تعلم آية كانت يوم قُتل الحسين بن علي؟ قال سعيد: نعم، ما قُلبت حصاة في بيت المقدّس يوم قُتل الحسين إلّا وُجد تحتها دم عبيط»[504].
دراسة سندية لخبر سعيد بن المسيّب
هذا الخبر لم نقف عليه بهذا السند إلّا عند ابن طاووس، فكتاب الفتن لزكريا بن يحيى بن الحارث النيشابوري لم يصل إلينا، ولم نقف على مَن نقله عنه من علماء أهل السنّة، مضافاً إلى أنّ في السند إرسال، فقد نقله هشام بن سعد عمّن حدّثه، عن سعيد بن المسيّب.
فالخبر ضعيف سنداً إلّا أنّه يُؤيّد ويُقوّي الطرق الأُخرى التي نصّت على الحادثة.
المبحث الثالث
إثبات أو نفي ظهور الدم تحت الأحجار
بعد هذه الجولة في دراسة الأسانيد ومعرفة طرق الخبر، والعلماء الذين أخرجوه من الفريقين، من الممكن وفق القواعد العلمية أنْ ننتهي إلى صحة هذه الحادثة وتحققها خارجاً؛ وذلك وفق قرائن عديدة، منها:
1 ـ تعدّد طرق الحديث حيث وردت خمسة أخبار في كُتب الشيعة، كما أنّه رُوي عن سبعة في كُتب السنّة، كما اتّفقت كُتب السنّة والشيعة على رواية الخبر عن الزهري، وهذه الروايات المختلفة وردت في مصادر مختلفة أيضاً، فلم تكن مقصورة على كتاب معيّن، فمثلاً من الكتب التي روت الخبر عند الشيعة: كتاب كامل الزيارات، وأمالي الشيخ الصدوق، وقصص الأنبياء للراوندي، والخرائج والجرائح للراوندي، وغيرها، كما أنّها وردت عند السنّة في كُتب عديدة: أخرجها الطبراني في معاجمه، وأخرجها البيهقي في دلائله، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبلاذري في أنسابه، وأبو الشيخ في كتاب السنّة، وابن سعد في الطبقات، وابن عساكر في تاريخه، وغيرهم ممّن تقدّم ذكرهم.
وتعدّد طرق الخبر وتعدّد مخارجه يُعتبر قرينة قوية على صحة الخبر وثبوت الواقعة، خصوصاً أنّ المسألة تتعلّق بقضية تأريخية، والقضايا التاريخية بطبيعة الحال تتحقق بهذا المقدار من التعدّد على مستوى الطرق والمصادر.
2 ـ إنّ هذا الخبر له بعض الأسانيد الصحيحة عند أهل السنّة، وهو خبر الزهري كما تبيّن عند دراسته، مضافاً لانجباره وتقويته ببقيّة الطرق التي تتعاضد مع بعضها، وهو المسمّى عند أهل السنّة بالحسن أو الصحيح لغيره، فبغض النظر عن تعدّد المخارج، فإنّه يكفي في ثبوت الخبر عند أهل السنّة أنْ يكون حسناً لغيره، ووفق القواعد العلمية، فإنّ هذا الخبر بغض النظر عن صحة بعض طرق الزهري سيكون في أقلّ حالاته حسناً لغيره؛ لأنّ أكثر طرقه إنّما ابتُليت ببعض المجاهيل، ولم يوجد فيها كذّابين أو متّهمين بالكذب، والمقرّر في علم المصطلح أنّ الخبر إذا تعدّد سنده بأنْ ورد من طريقين على الأقل، ولم يكن فيه كذّاباً ولا متّهماً، ولم يكن شاذّاً، صار حسناً لغيره، وقد تتكثر الطرق فيرتقي إلى الصحيح لغيره، وهذا متحقق في الخبر محلّ البحث.
كما أنّ الناظر في طرق الخبر الشيعية سيجد أنّ ثلاث طرق منها إنّما ابتُليت بالجهالة، ولم تبتلِ بتضعيف أو تكذيب رواتها، والمجهول حاله مختلف عن الضعيف، بمعنى أنّه أحسن حالاً منه، خصوصاً عند مَن يقول بأصالة العدالة في المسلم، فستكون هذه الأخبار صحيحة، وأمّا عند مَن لا يقول بأصالة العدالة في المسلم، فلا يبعد أنْ يحصل الوثوق من مجموع هذه الأخبار؛ لعدم وجود كذّاب ولا ضعيف فيها، فضلاً عن عدم معارضتها بغيرها، ولا معارضتها بالقرآن، وتأييدها بالأخبار المروية عند أهل السنّة.
كما عرفنا أنّه يمكن القول باعتبار خبر الزهري بناءً على اعتبار روايات أبي معشر كما تقدّم.
والخلاصة: إنّه بملاحظة طرق الرواية وتعدّدها، وصحة بعضها عند أهل السنّة، وعدم وجود الكذّابين في طرقها يتحقّق الوثوق بثبوت الخبر.
3 ـ يمكن أنْ نذكر هنا عين ما ذكرناه في الفصل الأوّل، من أنّ هذه الأخبار مروية في كتب الفريقين، بمعنى أنّه مع اختلاف العقائد وتباين الآراء والمشارب، ومع ذلك فقد اتفقت كلمة المسلمين من أهل الحديث والتاريخ على نقل هذه الحادثة وتدوينها في المصادر.
فلو أمكن لقائل أنْ يقول: إنّ هذه الحادثة تتماشى مع أهواء الشيعة وتتناغم مع عقيدتهم.
فإنّها بلا شكّ لا تنسجم ولا تتناغم مع هوى الطائفة الأُخرى.
ومن الطبيعي أنّ الحادثة ـ أيّ حادثة كانت ـ تكتسب القوة والتأييد كلّما اتفقت الأطراف المختلفة على نقلها، بغض النظر عمّا إذا اختلفت الأهواء والآراء، فكيف إذا اختلفت فيها الأنظار وكان لها تأثير عقدي كبير، فإنّ ذلك يزيدها قوةً وثبوتاً، خصوصاً أنّها تمثّل إقراراً من الطرف المقابل بما يمثّله الحسين من قيمة عُليا تهتز السماء والأرض لقتله، والإقرار في هكذا أُمور بنفسه يُشكّل قرينةً كبيرةً على صحة الحادثة ووقوعها؛ إذ لا معنى لأنْ يتعمّد الإنسان الكذب في أُمور لا تصبّ بمصلحته، وتكون نتيجتها مخالفة لعقيدته.
والخلاصة: إنّ نقل الحادثة من قِبل الفريقين يدفع أيّ شبهة يمكن أنْ تدّعى، بأنّ تلك الأخبار إنّما هي من وضع الشيعة؛ لأنّها تمثّل إقراراً من الطرف المقابل بحصولها.
أضف إلى ذلك أنّه عند الاختلاف في أمر معيّن لا مناص ولا وسيلة حينئذٍ إلّا بالرجوع إلى ما اتّفق عليه الفريقان؛ لأنّه طريق عقلائي يتّضح من خلاله الثابت من غيره، وهذا الطريق العقلائي متحقق في الحادثة المذكورة.
4 ـ تصريح بعض العلماء والمؤرّخين بوقوع تلك الحادثة، قال أبو نعيم: «وكسفت الشمس يوم موته، وصار الورس في عسكره رماداً، والمنحور من جذره دماً، لم يُرفع حجر بالشام إلّا رُئي تحته دم عبيط، وناحت الجنّ لرزيته وفقده»[505].
وجاء في مثير الأحزان: «قال البلاذري في مختاره: مطرت السماء دماً يوم قتله، وما قُلع حجر بالشام إلّا وتحته دم عبيط»[506].
وجاء في الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي: «وقال أبو سعيد: ما رُفع حجر من الدنيا إلّا وجد تحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دماً بقي أثره في الثياب مدّة حتّى تقطّعت»[507].
اتّضح ممّا قدّمنا أنّ جملة من الأخبار نصّت على ظهور الدم تحت الأحجار، وهنا نُريد أنْ نتأمّل قليلاً في هذه الأخبار، فهل بالإمكان أنْ يخرج الدم من الأرض؟ وهل كان ما شاهدوه هو دماً حقيقيّاً، أم كان هناك تحوّلاً واضطراباً كونياً احمرّت لأجله السماء والأرض؟ وهل حصل ذلك في جميع العالم أم في بعضه؟ ولماذا لم يصل إلينا بصورة متواترة؟ وما هي الدلالات الخاصّة التي يمكن أنْ تستفاد من هذه الأخبار؟
في الحقيقة لو تأمّلنا في أصل قضيّة ظهور الدم وخروجه من الأرض ضمن الموازين الطبيعية، فلا يمكن القول بخروج الدم، فإنّ الأرض لا يوجد فيها دم؛ لأنّ الدم كما هو معلوم، عبارة عن سائل أحمر يجري في داخل جسم الإنسان والحيوان من خلال الأوعية الدموية، الأوردة، والشرايين والشعيرات الدموية، وله وظائف عديدة: فله وظيفة تنفسية، ووظيفة غذائية، ووظيفية إخراجية (طرح الفضلات)، وغير ذلك، فلا يمكن حينئذٍ أنْ يكون الخارج من الأرض دماً حقيقيّاً؛ فإنّ الأرض من الجمادات التي ليس لها لا أوردة ولا شرايين ولا شعيرات، ولا تتنفس، ولا تأكل، ولا...، وحينئذٍ إمّا أنْ نتعامل مع الظاهرة وفق الإعجاز الكوني ونقول: إنّ ما حاصل بعد عاشوراء كان ظاهرة إعجازية، خارج نواميس ونظم الطبيعة، أو نفسّر ما حصل بشكل آخر يتناسب مع الظواهر الطبيعية، كأنْ يكون الظاهر هو سائل مصطبغ باللون الأحمر وظنّ الراوي أنّه دم.
وعند التأمّل في لسان الروايات المتعدّدة الواردة في الموضوع، تبرز أمامنا بعض الاحتمالات:
1 ـ أنْ يكون ما وجد تحت الحصاة والأحجار هو دم عبيط حقيقي، فإنّ المسألة إعجازية خالصة لها دلالاتها، باعتبار أنّ عاشوراء حالة استثنائية تمثّل تحوّلاً في واقع الأُمّة وعهداً جديداً في حياتها، خصوصاً أنّ بعض الروايات وردت عن الإمام الباقر×، والإمام حينما يُصرّح ويقول أنّه ما رُفع حجر إلّا ووجد تحته دم. فهذا معناه أنّه يريد الدم الحقيقي الواقعي.
2 ـ يمكن لقائل أنْ يقول: إنّ ما ورد عن الإمام الباقر× هو ضعيف السند، وإنّما ثبت أصل الموضوع بمجموع الروايات، وبقيّة الروايات سواء عند الشيعة أو أهل السنّة إنّما وردت على لسان الرواة، فلا يمكن أنْ نجزم أنّ الخارج دماً حقيقيّاً حتى مع تصريح الرواة بأنّه دم عبيط، فإنّ الراوي عرضة للخطأ والاشتباه، فقد يكون رأى سائلاً أحمر ظهر تحت الصخور فتوهم أنّه دم.
لكن هذا الاحتمال لا يغيّر من روح الموضوع وحقيقته؛ إذ لا يتسنى لنا معرفة ذلك السائل ولا كنهه، فهو أيضاً يمثّل حالة غير طبيعة حصلت للأرض عند مقتل الحسين×.
3 ـ أنْ يكون ذلك الدم المتولّد تحت الصخور إنّما هو نتيجة مطر السماء دماً وليس أمراً جديداً، فما يقال هناك يقال هنا.
لكن هذا الاحتمال ليس له ما يؤيّده، فمن غير الواضح أنْ يكون الحاصل حادثة واحدة، خصوصاً أنّ الحادثتين وردتا على لسان أهل البيت^، فيتعيّن الجزم بكونهما حادثتين لولا أنّ الحادثة التي نحن بصددها وردت بسند ضعيف.
والخلاصة: إنّ الأوفق المتطابق مع لسان الروايات هو أنّ الذي رأوه دماً حقيقيّاً، خصوصاً أنّ بعضهم صرّح بأنّه دم عبيط، أي: طري.
وأمّا أنّ الحادثة هل حصلت في جميع العالم أم في بعض مناطقه فغير واضح؛ إذ إنّ بعض الأخبار نصّت على أنّ ذلك في بيت المقدس، ونصّ بعضها الآخر على أنّ ذلك حصل في بلاد الشام، وورد مرسلاً عن ابن عباس أنّ ذلك حصل في الدنيا كلّها، ويؤيّده إطلاق بعض الأخبار التي لم تُقيّد ظهور الدم في بقعة معيّنة، خصوصاً أنّ منها ما ورد عن الإمام الباقر×، فهي مطلقة وغير مقيّدة بمكان معيّن.
أمّا ما يتعلّق بأخبار بيت المقدس وبلاد الشام فغير مختلفة؛ إذ إنّ بيت المقدس هي جزء من بلاد الشام، فقد يكون المراد شيء واحد وهو بيت المقدس، خصوصاً أنّ الزهري بنفسه تارةً ذكر بيت المقدس، وأُخرى ذكر بلاد الشام، إلّا أنّه يمكن القول أيضاً أنّ الدم ظهر في بيت المقدس وفي أجزاء أُخرى من بلاد الشام، وكلٌّ أخبر عمّا شاهده وعرفه.
وأمّا الأخبار المطلقة، فبالنسبة للصادرة من غير الإمام لا يمكن الاستفادة من إطلاقها التعميم؛ إذ إنّ الراوي يُخبر عمّا علمه وشاهده في مدينته التي يسكن بها، ولا علم له بما جرى في جميع الدنيا، إلّا أنْ يقال: إنّ المسألة كانت معروفة ومشهورة بينهم، فكان الراوي يطلق القول فيها.
وأمّا ما ورد عن الإمام×، فهو مطلق ويمكن التمسّك به إلّا أنّ الخبر ضعيف وليس صحيح سنديّاً.
نعم، يمكن القول: إنّ عِظم المصيبة والمأساة وكبر الجريمة يقتضي أنْ يهتز الكون بأجمعه لأجلها، ولا معنى لانحصاره في مكان معيّن، فالمقتول يمثّل إمام العالم بأجمعه، وابن بنت نبيّ هذه الأُمّة، والجريمة اقتُرفت بشكل فظيع، وما حدث كان أشبه بنزول العذاب على الأُمّة، فاحتمال حصول ذلك في جميع الدنيا أمر وارد في حدّ ذاته، وجاءت الأخبار مؤيدة ومقوّية لحصول ذلك.
وأمّا ما قد يقال أنّه لو كانت هذه الحادثة حصلت في جميع العالم، فلمّاذا لم تصل إلينا بصورة متواترة؟ فالجواب هو عين ما تقدّم في مسألة مطر السماء دماً، فلا نُعيد.
وأمّا الدلالات الخاصّة التي يمكن أنْ نستفيدها من ظهور الدم تحت الأحجار، فهي كسابقتها في نزول المطر ولا تختلف عنها، فيمكن أنْ نقول أنّها تمثل حالة البكاء التي حصلت من السموات والأرض على الحسين×، فظهور الدم يمثّل حالة من الحزن الشديد الحاصلة على الحسين×، والتي بلغت حدّاً أنْ تبكي عليه السماء والأرض، وسيأتي لاحقاً بيان الروايات الدالة على البكاء ونبيّن الموضوع بصورة أكثر هناك، ونوّضح معنى بكاء السموات والأرض بصورة أجلى.
وقد أشار ونوّه إلى هذا المعنى الشيخ المجلسي&، حيث قال في توجيهه لبكاء السموات والأرض: «ويمكن أنْ يقال: كناية عن شدّة المصيبة حتّى كأنّه بكى عليه السماء والأرض، أو عن أنّه وصل ضرر تلك المصيبة إلى السماء والأرض وأثرت فيهما، وظهر بها آثار التغيّر فيهما، أو أنّه أمطرت السماء دماً، وكان يتفجّر الأرض دماً عبيطاً، فهذا بكاؤهما كما فسّر به في الخبر، ولعلّ الأخير أظهر»[508].
كما أنّ إدراج الشيخ ابن قولويه روايات ظهور الدم تحت الأحجار في باب (بكاء السماء والأرض على قتل الحسين×، ويحيى بن زكريا) يُشير إلى أنّه يرى أنّ ذلك كناية عن بكاء الأرض على الحسين×.
كما أنّها كناية عن شدّة غضب الباري (عزّ وجلّ) عمّا حصل من عظم المصيبة، وفداحة الخطب، وعمق الجريمة، فالمقتول هو ابن بنت رسول الله، بطريقة مهولة يندى لها جبين الأنسانية، فلا عجب حينئذٍ أنْ تظهر الدماء تحت الأحجار مسجّلة حالة من الغضب والسخط على هؤلاء القوم.
كما أنّ لها دلالات عامّة كثيرة نُشير إليها لاحقاً حين التكلّم عن دلالات جميع هذه الأحداث.
الفصل الثالث : بكاء السماوات والأرض على الحسين ×
1 ـ إبراهيم النخعي.
2 ـ أبو بصير.
3 ـ خبر عبد الله بن هلال.
4 ـ رجل عن أمير المؤمنين.
5 ـ محمد بن علي الحلبي.
6 ـ داوُد بن فرقد.
7 ـ عبد الخالق بن عبد ربّه.
8 ـ جابر الجعفي.
9 ـ كليب بن معاوية.
10ـ عمرو بن ثبيت، عن أبيه.
11 ـ حنان بن سدير.
12 ـ الحسن بن زياد.
13 ـ كثير بن شهاب.
14 ـ أبو سلمة.
15 ـ ميثم التمّار.
16 ـ الفضيل الهمداني.
17 ـ إسحاق الأحمر.
18 ـ إسماعيل بن كثير.
19 ـ الحسين بن ثوير.
20ـ يونس بن ظبيان.
21 ـ أبو سلمة السراج.
22 ـ المفضّل بن عمر.
23 ـ زرارة بن أعين.
24 ـ أبو حمزة الثمالي
ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سنديّاً
بعد التتبع وقفنا على عدد كثير من الروايات الدالّة على مسألة البكاء، فقد رواها ما يقارب (24) راوٍ، والطرق إليهم عديدة جدّاً؛ لذا لم نجد مبرّراً لدراسة كافّة الأسانيد بصورة مفصّلة، خصوصاً أنّ أكثر الروايات متوافقة في المعنى، وعليه سنقوم بدراسة مجموعة معيّنة من هذه الروايات، خصوصاً التي تحمل بعض الإضافات المؤثرة في معنى الحديث، ونترك البقيّة اكتفاءً بذلك.
فالمبحث حينئذٍ سينقسم على قسمين، أحدهما: يتعلّق بتخريج جميع الأخبار المتعلّقة ببكاء السموات والأرض، مع إعطاء الحكم النهائي للسند من حيث الصحة والضعف. والآخر: يتعلّق بنماذج من الروايات يتم دراستها سنديّاً بصورة مجملة.
الأوّل: تخريج الروايات مع الحكم عليها سنديّاً
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن داوُد بن عيسى الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلي، عن إبراهيم النخعي، قال: خرج أمير المؤمنين×، فجلس في المسجد واجتمع أصحابه حوله، وجاء الحسين× حتى قام بين يديه، فوضع يده على رأسه، فقال: يا بني، إنّ الله عبر أقواماً بالقرآن، فقال: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) [509]، وأيم الله ليقتُلنك بعدي، ثمّ تبكيك السماء والأرض».
وقال: «وحدّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب باسناده مثله»[510].
وهذا الإسناد ضعيف، ويكفي في ذلك جهالة داوُد (يزداد)[511] بن عيسى الأنصاري.
وورد قريب من هذا الخبر مرسلاً عن الباقر، عن علي×، أورده ابن شهر آشوب، حيث ذكر عن الباقر× في تفسير قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ): «وذلك أنّ علياً خرج قبل الفجر متوكئاً على عنزة، والحسين خلفه يتلوه، حتّى أتى حلقة رسول الله، فرمى بالعنزة، ثمّ قال: إنّ الله تعالى ذكر أقواماً، فقال: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ)، والله ليقتُلنه ولتبكي السماء عليه»[512].
أخرجه ابن قولويه، قال: «وحدّثني محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص النحاس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله×، قال: إنّ الحسين× بكى لقتله السماء والأرض واحمرّتا، ولم تبكيا على أحد قطُّ إلّا على يحيى بن زكريا، والحسين بن علي÷».
وقال: «وحدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين باسناده مثله»[513].
وهذا الإسناد معتبر (موثّق) على ما سيأتي لاحقاً.
أخرجه ابن قولويه، قال: «وحدّثني علي بن الحسين بن موسى بن بابويه وغيره، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله بن هلال، قال: سمعت أبا عبد الله×، يقول: إنّ السماء بكت على الحسين بن علي، ويحيى بن زكريا، ولم تبكِ على أحد غيرهما. قلت: وما بكاؤهما[514]؟ قال: مكثوا أربعين يوماً تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت: فذاك بكاؤهما؟ قال: نعم»[515].
وقال أيضاً: «وحدّثني أبي، وعلي بن الحسين (رحمهما الله جميعاً)، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله×، قال: سمعته يقول: إنّ السماء بكت على الحسين بن علي، ويحيى بن زكريا، ولم تبكِ على أحد غيرهما. قلت: وما بكاؤها؟ قال: مكثوا أربعين يوماً تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت: فذاك بكاؤها؟ قال: نعم»[516].
وهذا السند ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن هلال الراوي المباشر، فقد ذكره الشيخ في أصحاب الصادق× ولم يورد فيه جرحاً ولا توثيقاً، وقال: «عبد الله بن هلال، عربي كوفي جعفي»[517].
وذهب بعضهم إلى اتحاده مع عبد الله بن هلال بن جابان، مع أنّ الشيخ الطوسي ذكر كلّ واحد منهما على حده، إلّا أنّ السيّد الخوئي لا يرى الاتحاد، خصوصاً مع تصريح الشيخ بأنّ الأوّل عربي، بخلاف الثاني فإنّه مولى على الظاهر، وما يؤكد ذلك اسم جدّه جابان أو خاقان وهما ليسا من الأسماء العربية[518].
ثمّ إنّ الثاني مجهول أيضاً، لكن الثمرة تظهر في أنّ الثاني يروي عنه الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع، فيمكن التمسّك بصحة رواياته وفق المبنى المعروف في أصحاب الإجماع.
نعم وفق المبنى القائل بوثاقة جميع رجال كتاب كامل الزيارات تكون الرواية معتبرة.
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبي&، وجماعة مشايخنا، وعلي بن الحسين، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن علي الأزرق، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن رجل، قال: سمعت أمير المؤمنين×، وهو يقول في الرحبة، وهو يتلو هذه الآية: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) [519]، وخرج عليه الحسين من بعض أبواب المسجد، فقال: أما إنّ هذا سيُقتل وتبكي عليه السماء والأرض»[520].
وهذا الخبر أيضاً ضعيف؛ ويكفي في ذلك جهالة الرجل الذي سمع أمير المؤمنين×.
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله× في قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ) ، قال: لم تبكِ السماء على أحد منذُ قُتل يحيى بن زكريا حتى قُتل الحسين×، فبكت عليه»[521].
وهذا السند رجاله كلّهم ثقات على كلام في المفضّل بن صالح (أبي جميلة).
وأورده الراوندي في قصص الأنبياء: «وعن ابن بابويه، عن أبيه، حدّثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله في قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ) ، قال: لم تبكِ السماء على أحدٍ قبل قتل يحيى بن زكريا حتى قُتل الحسين×، فبكت عليه»[522].
ولابن قولويه فيه طريقان، يختلفان في بعض الألفاظ:
الأوّل: قال ابن قولويه: «وحدّثني محمد بن جعفر الرزاز القرشي، قال: حدّثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن داوُد بن فرقد، عن أبي عبد الله×، قال: احمرّت السماء حين قُتل الحسين× سنة، ويحيى بن زكريا، وحمرتها بكاؤها»[523].
وهذا السند صحيح رجاله كلّهم إمامية ثقات على ما سيأتي.
الثاني: قال ابن قولويه أيضاً: «حدّثني أبي، عن محمد بن الحسن بن مهزيار، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داوُد بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: كان الذي قتل الحسين بن علي÷ ولد زنا، والذي قتل يحيى بن زكريا ولد زنا، وقال: احمرّت السماء حين قُتل الحسين بن علي سنة، ثمّ قال: بكت السماء والأرض على الحسين بن علي، وعلى يحيى بن زكريا وحمرتها بكاؤها»[524].
وهذا السند ضعيف؛ لجهالة الحسن بن مهزيار.
7 ـ خبر عبد الخالق بن عبد ربّه
أخرجه ابن قولويه، قال: «وحدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الخالق بن عبد ربّه، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا)، الحسين بن علي، لم يكن له من قَبلُ سميّاً، ويحيى بن زكريا× لم يكن له من قَبلُ سميّا، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً. قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء»[525].
وهذا السند معتبر (موثّق) رجاله كلّهم ثقات، على ما سيأتي.
وأورده السيّد شرف الدين الأسترابادي، وكذلك السيّد هاشم البحراني، عن القمّي، علي بن إبراهيم، بسنده «عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد الله ـ× ـ يقول في قول الله (عزّ وجلّ): (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا)، فقال: الحسين ـ× ـ لم يكن له من قَبلُ سميّا، ويحيى بن زكريا لم يكن له من قَبلُ سميّا، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً. قلت: فما [كان] بكاؤها؟ قال: كانت الشمس تطلع حمراء وتغيب حمراء»[526].
والخبر بهذا السند لا يختلف عن سابقه من حيث الدلالة؛ لذا فالكلام في ثبوت أو عدم ثبوت تفسير القمّي لا يجدي كثير نفع، إلّا أنّه على القول بثبوت التفسير ووثاقة جميع رجاله، وكذا على القول بثبوت قسم من التفسير لعلي بن إبراهيم ووثاقة رجاله أيضاً، فإنّ ذلك يعطي قوّة أكثر للرواية.
إلّا أنّه بعد البحث والتنقيب لم نعثر على هذه الرواية في تفسير القمّي، فلعلّها ساقطة من النُّسخ الواصلة إلينا إنْ كان الواصل إلينا هو تفسير القمّي على الخلاف الشديد الذي فيه، وحينئذ يحتمل أنّ هذه الرواية موجودة في نسخة تفسير القمّي الأصل، والله العالم.
وقد ذكر السيّد شرف الدين الاسترابادي وجهاً آخر للخبر مضافاً لطريق القمّي المتقدّم،، فقال بعد ذكره الآية الشريفة:
تأويله: قال محمّد بن العباس&: قال: «حدّثنا حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسين بن بكر، قال: حدّثنا الحسن بن علي بن فضّال بإسناده إلى عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد الله ـ× ـ يقول في قول الله (عزّ وجلّ): (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا) قال: ذلك يحيى بن زكريا ـ ÷ ـ لم يكن له من قَبلُ سميّا، وكذلك الحسين ـ× ـ لم يكن له من قَبلُ سميّا، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً. قلت: فما كان بكاؤها ؟ قال: تطلع الشمس حمراء»[527].
والخبر هذا مبتلى بالإرسال، فلم يذكر سند ابن فضّال إلى عبد الخالق، ولعلّه نفس السند السابق، كما أنّ السيّد شرف الدين متوفّى في سنة (965هـ)، وهو ينقل من كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت لمحمد بن العباس، وثبوت النُّسخة التي عثر عليها السيّد شرف الدين، وأكثر من النقل عنها، يحتاج إلى تحقيق، فإنّها لم تصل إلينا.
وكيف ما كان، فإنّ الخبر بسنده الذي نقله ابن قولويه هو سند معتبر موثّق.
أخرجه ابن قولويه، قال: «وحدّثني علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن إبراهيم، وسعد بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر×، قال: «ما بكت السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلّا على الحسين بن علي÷، فإنّها بكت عليه أربعين يوماً»[528].
وهذا السند رجاله كلّهم ثقات على كلام في المفضّل بن صالح (أبي جميلة).
أخرجه ابن قولويه قال: «حدّثني محمد بن جعفر الرزاز الكوفي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبد الله×، قال: «لم تبكِ السماء إلّا على الحسين بن علي، ويحيى بن زكريا÷»[529].
وهذا السند صحيح، رجاله كلّهم ثقات على كلام وخلاف بسيط في كليب بن معاوية، غير أنّ الصحيح وثاقته[530].
وأخرجه ابن قولويه في موضع آخر، بلفظ يزيد على سابقه، قال: «حدّثني أبي&، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن كليب بن معاوية، عن أبي عبد الله×، قال: كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زنا، وكان قاتل الحسين× ولد زنا، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما»[531].
وهذا السند كسابقه رجاله كلّهم ثقات على ما سيأتي.
وهناك طريق آخر ذكره ابن قولويه، قال: «حدّثني محمد بن الحسن، ومحمد بن أحمد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسن، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبد الله× مثله»[532].
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني حكيم بن داوُد بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن عيسى، عن أسلم بن القاسم، قال: أخبرنا عمرو بن ثبيت، عن أبيه، عن علي بن الحسين÷، قال: إنّ السماء لم تبكِ منذُ وُضعت إلّا على يحيى بن زكريا، والحسين بن علي÷. قلت: أي شيء كان بكاؤها؟ قال: كانت إذا استُقبلت بثوب وقع على الثوب شبه أثر البراغيث من الدم»[533].
وقد تقدّم دراسة هذا الحديث سابقاً، وتحصّل أنّ السند فيه عدّة من المجاهيل، فبناءً على تمامية قاعدة أصحاب الإجماع ـ وهم الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، بمعنى أنّ الرواية تكون صحيحة بمجرد صحّة السند إلى أحدهم من دون حاجة إلى بحث بقيّة السند ـ فتكون الرواية صحيحة، وإلّا فهي ضعيفة.
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبي&، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن حنان، قال: قلت لأبي عبد الله×: ما تقول في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين×، فإنّه بلغنا عن بعضهم أنّها تعدل حجة وعمرة؟ قال: لا تعجب، ما أصاب مَن يقول هذا كلّه، ولكن زره ولا تجفه؛ فإنّه سيّد الشهداء، وسيّد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والأرض»[534].
وهذا السند ضعيف؛ لجهالة موسى بن الفضل، وسيأتي بعد قليل سند آخر صحيح لهذا الحديث.
وقال ابن قولويه: «حدّثني أبي، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله× مثله سواء»[535].
وأخرجه الحميري في قرب الإسناد، قال: «وعنهما [أي: محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد حسب ما تقدّما في أسانيده السابقة]، عن حنان بن سدير، قال: قلت لأبي عبد الله×: ما تقول في زيارة قبر الحسين×؟ فإنّه بلغنا عن بعضكم أنّه قال: تعدل حجّة وعمرة. قال: فقال: ما أضعف هذا الحديث، ما تعدل هذا كلّه، ولكن زوروه ولا تجفوه. فإنّه سيّد شباب الشهداء، وسيّد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والأرض»[536].
وهذا السند يمكن القول بصحّته؛ إذ إنّ رواته من الإمامية الثقات باستثناء عبد الصمد بن محمد الأشعري، فلم يرد فيه جرح ولا توثيق، لكنّ رواية الأجلّاء عنه كمحمد بن الحسن الصفّار، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، قد تُوجب القول بوثاقته.
كما أنّ عبد الصمد لم ينفرد، بل تابعه محمد بن عبد الحميد، وهو الآخر فيه كلام بين التوثيق والجهالة.
ولا نجد حاجة للبحث مُفصّلاً؛ لأنّ السند القادم هو سند صحيح.
وقال ابن قولويه: «حدّثني أبي (رحمه الله تعالى)، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله× مثله»[537].
وهذا السند صحيح، رجاله كلّهم من الإمامية الثقات.
قال ابن قولويه: «وبهذا الاسناد [أي: حدّثني أبي (رحمه الله تعالى)، وجماعة مشايخي]، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن غير واحد، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن عامر بن معقل، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله×، قال: كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زنا، وقاتل الحسين× ولد زنا، ولم تبكِ السماء على أحد إلّا عليهما. قال: قلت: وكيف تبكي؟ قال: تطلع الشمس في حمرة وتغيب في حمرة»[538].
وقال: «حدّثني محمد بن جعفر القرشي، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير بإسناده مثله»[539].
وهذا السند ضعيف؛ لجهالة عامر بن معقل.
أخرجه ابن قولويه، قال:« وعنهما [يعني أبيه، وعلي بن الحسين (رحمهما الله جميعاً)]، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن البرقي محمد بن خالد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن كثير بن شهاب الحارثي، قال: بينما نحن جلوس عند أمير المؤمنين× في الرحبة إذ طلع الحسين× عليه، فضحك علي× ضحكاً حتّى بدت نواجده، ثمّ قال: إنّ الله ذكر قوماً وقال: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ليقتلن هذا ولتبكين عليه السماء والأرض»[540].
وقال: «حدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني العلوي، عن الحسن بن الحكم النخعي، عن كثير بن شهاب الحارثي، قال: بينما نحن جلوس عند أمير المؤمنين× بالرحبة إذ طلع الحسين×، قال: فضحك علي× حتى بدت نواجده، ثمّ قال: إنّ الله ذكر قوماً، فقال: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، ليقتلن هذا ولتبكين عليه السماء والأرض»[541].
وهذا السند ضعيف؛ فالحسن بن الحكم النخعي مجهول لم يذكروه.
وكثير بن شهاب مجهول أيضاً، بل دلّت بعض الأخبار على سوء سريرته، وكان يُخذّل الناس عن نصرة مسلم بن عقيل[542].
أضف إلى ذلك لم يتسنَ لنا وجه ضحك الإمام علي× بالطريقة التي يصوّرها الراوي، فالموقف كان يحتمل البكاء أكثر من الضحك، فلعلّ الإمام بكى بشدّة حين رأى الحسين وتخيّل الراوي أنّه ضحك، أو أنّ الراوي نسج هذا الضحك من مخيّلته والله أعلم.
قال ابن قولويه: «وحدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد العظيم، عن الحسن، عن أبي سلمة، قال: قال جعفر بن محمد÷: ما بكت السماء والأرض إلّا على يحيى بن زكريا والحسين÷»[543].
وهذا السند ضعيف أيضاً؛ ويكفي في ضعفه وجود الحسن بن الحكم النخعي، وهو مجهول لم يذكروه.
أخرجه الشيخ الصدوق، قال: «حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس&، قال: حدّثنا أبي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن أرطأة بن حبيب، عن فضيل الرسان، عن جبلة المكية، قالت: سمعت ميثما التمار (قدس الله روحه) يقول: والله لتقتلن هذه الأُمّة ابن نبيّها في المُحرّم لعشر يمضين منه، وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة، وإنّ ذلك لكائن، قد سبق في علم الله (تعالى ذكره)، أعلم ذلك بعهد عهده إليّ مولاي أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، ولقد أخبرني أنّه يبكي عليه كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات، والحيتان في البحار، والطير في جو السماء، وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم، والسماء والأرض، ومؤمنو الإنس والجنّ، وجميع ملائكة السماوات، ورضوان ومالك وحملة العرش، وتمطر السماء دماً ورماداً. ثمّ قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين×، كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وكما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس.
قالت جبلة: فقلت له: يا ميثم، وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يُقتل فيه الحسين بن علي÷ يوم بركة؟! فبكى ميثم (رضي الله عنه)، ثمّ قال: سيزعمون بحديث يضعونه أنّه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم×، وإنّما تاب الله على آدم× في ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي قبل الله فيه توبة داوُد×، وإنّما قَبِل الله توبته في ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس× من بطن الحوت، وإنّما أخرجه الله تعالى من بطن الحوت في ذي القعدة، ويزعمون أنّه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح× على الجودي، وإنّما استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل، وإنّما كان ذلك في ربيع الأوّل.
ثمّ قال ميثم: يا جبلة، اعلمي أنّ الحسين بن علي÷ سيّد الشهداء يوم القيامة، ولأصحابه على سائر الشهداء درجة. يا جبلة، إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنّها دم عبيط، فاعلمي أن سيّدك الحسين قد قُتل.
قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت الشمس على الحيطان كأنّها الملاحف المعصفرة[544]، فصحت حينئذٍ وبكيت، وقلت: قد والله قُتل سيّدنا الحسين بن علي×»[545].
وقد تقدّمت دراسة هذا الخبر، وتبيّن أنّه ضعيف لجهالة جبلة المكيّة.
16 ـ خبر الفضيل الهمداني عن أبيه
أخرجه القمّي في تفسيره، بعد ذكر الآية: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)، قال: «حدّثني أبي، عن حنان بن سدير، عن عبد الله بن الفضيل الهمداني، عن أبيه، عن جدّه، عن أمير المؤمنين×، قال: مرّ عليه رجل عدو لله ولرسوله، فقال: (وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين)، ثمّ مرّ عليه الحسين بن علي÷، فقال: لكن هذا ليبكين عليه السماء والأرض، وقال: وما بكت السماء والأرض إلّا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي÷»[546].
وهذا السند صحيح، بناءً على وثاقة جميع رجال تفسير القمّي كما يذهب إليه السيّد الخوئي. وكذلك صحيح بناءً على أنّ تفسير القمّي قسمان أحدهما لأبي الجارود والآخر للقمّي، ووثاقة جميع رجال القسم المختص للقمّي؛ لأنّ هذه الرواية من القسم التابع للقمّي كما هو واضح من سندها.
أمّا بناءً على عدم ثبوت تفسير القمّي من الأساس، فتكون الرواية ضعيفة.
ورد في مناقب آل أبي طالب: سأل إسحاق الأحمر الحجّة (الإمام المهدي) عجّل الله تعالى فرجه الشريف، عن قول الله تعالى: (كهيعص) [547].
فكان ممّا جاء في آخر جوابه: «... وكان حمل يحيى ستّة أشهر، وحمل الحسين ستة أشهر، وذُبح يحيى كما ذُبح الحسين، ولم تبكِ السماء والأرض إلّا عليهما»[548].
ومن الواضح أنّ هذا الخبر ضعيف بالإرسال، ولم نقف على سنده.
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن الفضّال، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن كثير، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: كان قاتل الحسين بن علي ولد زنا، وكان قاتل يحيى بن زكريا ولد زنا، ولم تبكِ السماء والأرض إلّا لهما وذكر الحديث»[549].
مروان بن مسلم ثقة[550].
وإسماعيل بن كثير، مجهول لم يذكروه.
فالسند ضعيف.
خبر هؤلاء الأربعة أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن عبد الجبار النهاوندي، عن أبي سعيد، عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، ويونس بن ظبيان، وأبي سلمة السراج، والمفضّل بن عمر، كلّهم قالوا: سمعنا أبا عبد الله× يقول: إنّ أبا عبد الله الحسين بن علي÷ لمّا مضى، بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ، ومَن ينقلب عليهنّ، والجنّة والنار، وما خلق ربنا، وما يُرى وما لا يُرى»[551].
والخبر صحيح كما سيأتي، لكنّه بهذا السند ضعيف، ويكفي في ذلك وجود الحسن بن علي بن أبي عثمان، فقد ضعّفه الأصحاب كما نص النجاشي على ذلك، مضافاً لفساد عقيدته وكونه من الفرقة العليائية، بل يظهر من بعض الأخبار كفره[552].
وقال ابن قولويه أيضاً: «وحدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان باسناده مثله»[553].
وهذا السند كسابقه في الضعف؛ لكونه من طريق الحسن بن علي بن أبي عثمان أيضاً.
وقال ابن قولويه: «وحدّثني أبي، عن سعد بن عبد الله، عن الحسين بن عبيد الله، عن الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن عبد الجبار النهاوندي، عن أبي سعيد، عن الحسين بن ثوير، عن يونس، وأبي سلمة السراج، والمفضّل بن عمر، قالوا: سمعنا أبا عبد الله× يقول: لمّا مضى الحسين بن علي÷، بكى عليه جميع ما خلق الله إلّا ثلاثة أشياء: البصرة، ودمشق، وآل عثمان»[554].
وهذا السند فيه الحسن بن علي بن أبي عثمان أيضاً.
وقال ابن قولويه أيضاً: «حدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان، والمفضّل بن عمر، وأبو سلمة السراج، جلوساً عند أبي عبد الله×، فكان المتكلّم يونس، وكان أكبرنا سناً ـ وذكر حديثاً طويلاً، يقول: ـ ثمّ قال أبو عبد الله×: إنّ أبا عبد الله× لمّا مضى، بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، وما ينقلب في الجنّة والنار من خلق ربنا، وما يُرى وما لا يُرى، بكى على أبي عبد الله إلّا ثلاثة أشياء لم تبكِ عليه. قلت: جُعلت فداك، ما هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: لم تبكِ عليه البصرة، ولا دمشق، ولا آل عثمان بن عفان. وذكر الحديث»[555].
وهذا السند صحيح معتبر، رجاله إمامية ثقات على ما سيأتي لاحقاً.
وأخرجه الكليني في الكافي مفصّلاً، عن: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير، قال: كنت أنا، ويونس بن ظبيان، والمفضّل بن عمرو (أبو سلمة السراج) جلوساً عند أبي عبد الله×، وكان المتكلّم منّا يونس، وكان أكبرنا سنّاً...»[556]. وذكر حديثاً مفصّلاً، من جملته ما ذكره ابن قولويه فيما تقدّم.
وهذا السند صحيح معتبر أيضاً كما سيأتي لاحقاً.
وأخرجه الشيخ الطوسي في الأمالي، قال: «حدّثنا أبو عبد الله محمد بن محمد، قال: حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد&، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي فاختة، قال: كنت أنا، وأبو سلمة السراج، ويونس بن يعقوب، والفضيل بن يسار، عند أبي عبد الله جعفر بن محمد÷، فقلت له: جعلت فداك، إنّي أحضر مجالس هؤلاء القوم...، إلى أنْ قال: إنّ أبا عبد الله الحسين× لمّا قُتل بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنّة والنار، وما يُرى وما لا يُرى، إلّا ثلاثة أشياء، فإنّها لم تبكِ عليه. فقلت: جعلت فداك، وما هذه الثلاثة أشياء التي لم تبكِ عليه؟ فقال: البصرة، ودمشق، وآل الحكم بن أبي العاص»[557].
وهذا السند صحيح، رجاله كلّهم إمامية ثقات على ما سيأتي.
أخرجه ابن قولويه: «حدّثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن علي بن محمد بن سالم، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن حمّاد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم، عن أبي يعقوب، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: قال أبو عبد الله×: يا زرارة، إنّ السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم، وإنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد، وإنّ الشمس بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرة، وإنّ الجبال تقطعت وانتثرت، وإنّ البحار تفجّرت، وإنّ الملائكة بكت أربعين صباحاً على الحسين×...»[558].
وهذه الرواية ضعيفة؛ ويكفي في ذلك جهالة علي بن محمد بن سالم.
وجهالة عبد الله بن حمّاد البصري.
وكذلك ضعف عبد الله بن عبد الرحمن الأصم؛ حيث قال عنه النجاشي: «ضعيف غالٍ، ليس بشيء... له كتاب المزار، سمعت ممن رآه فقال لي: هو تخليط»[559]. وذكره العلّامة في القسم الثاني، وقال فيه: «بصري ضعيف غالٍ، ليس بشيء، وله كتاب في الزيارات يدلّ على خبث عظيم، ومذهب متهافت، وكان من كذّابة أهل البصرة»[560].
ومن الواضح أنّ العلاّمة قد اعتمد في ترجمته هذه على كتاب النجاشي وكتاب ابن الغضائري، وحيث إنّ كتاب ابن الغضائري لم يثبت استناده إليه، فيبقى كلام النجاشي هو المعتمد في الحكم على الرجل.
لذا قد تختلف الآراء حسب فهم وتفسير كلمات النجاشي، فذهب السيد الخوئي إلى ضعف الرجل، حيث قال: «ظاهر كلام النجاشي أنّه ليس بشئ، أنّه ضعيف في الحديث، فلا اعتماد على رواياته»[561].
لكن قد يقال إنّ سبب تضعيف الرجل هو اتّهامه بالغلو، فإذا أمكن الوقوف على حقيقة الرجل، وأنّه غير مغال، زال سبب التضعيف، وهناك كلمات للشيخ الوحيد البهبهاني في دفع الغلو عن الرجل، وتبرئة ساحته[562].
وكيفما كان، فالرواية ضعيفة من حيث السند لجهالة بعض الرواة كما تقدّم.
نعم، بناء على وثاقة كلّ رجال كتاب كامل الزيارات، مع ملاحظة عدم ثبوت ضعف عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، فحينئذ يمكن القول باعتبار الرواية.
أخرجها ابن قولويه، قال: «حدثني أبو عبد الرحمان محمد بن أحمد بن الحسين العسكري ومحمد بن الحسن جميعاً، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه علي بن مهزيار، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن مروان، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال الصادق×: إذا أردت المسير إلى قبر الحسين...»، وذكر الإمام× آداب زيارة الحسين وكيفيّتها، وممّا جاء في كلامه: «بأبي أنت وأمي يا سيدي، بكيتك يا خيرة الله وابن خيرته، وحق لي أن أبكيك، وقد بكتك السماوات والأرضون والجبال والبحار، فما عذري ان لم أبكك ، وقد بكاك حبيب ربي، وبكتك الأئمة صلوات الله عليهم، وبكاك من دون سدرة المنتهى إلى الثرى جزعاً عليك»[563].
ورجال هذه الرواية كلّهم من الثقات باستثناء محمّد بن مروان فهو مجهول، وقد روى عنه في هذا الخبر محمّد بن أبي عمير، وهو من أصحاب الإجماع الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحّ عنهم، فإن قلنا بأنّ مفاد هذه القاعدة هو وثاقة كلّ بقية رواة السند أو صحّة الحديث، فستكون هذه الرواية صحيحة، وإنْ لم نقبل ذلك فالحديث ضعيف؛ بسبب جهالة محمد بن مروان.
من الواضح أنّ الروايات المتقدّمة وإنْ اتّفقت جميعها على حصول البكاء، إلّا أنّها لم تكن بلسان واحد، ولم تقتصر على معنى معيّن، بل تفاوتت من واحدة إلى أُخرى؛ لذا سنقف على أهمّ ما جاءت به الروايات في خصوص ما يتعلّق بالبكاء، ولا نتطرّق لمِا كان خارج ذلك، إذ إنّ بعض الروايات فيها معانٍ أُخرى خارجة عن محلّ الكلام في مبحثنا هذا.
فمن الأُمور التي يمكن استفاداتها من هذه الروايات العديدة، والتي تتعلّق بموضوع البكاء، ما يلي:
1 ـ إنّ الروايات اتّفقت على أصل حادثة البكاء، وهذا المعنى يكاد يكون متحصّل في جميع الروايات المتقدّمة، سوى أنّ بعض الروايات اقتصر على بكاء السماء: كرواية عبد الله بن هلال، ورواية محمد بن علي الحلبي، وجابر الجعفي، وعبد الخالق بن عبد ربّه، وكليب بن معاوية، والحسن بن زياد، وثبيت، في حين صرّحت مجموعة أُخرى بأنّ البكاء حصل من السموات والأرض، وهي كثيرة جدّاً: كرواية أبي بصير، وداوُد بن فرقد، وحنان بن سدير، وكثير بن شهاب، والحسين بن ثوير، وغيرها ممّا تقدّم في التخريج.
فبكاء السموات والأرض ثابت لا ريب فيه، خصوصاً مع وجود عدّة من الروايات الصحيحة في ذلك.
2 ـ إنّ طائفة من الروايات أثبتت حصول البكاء على الحسين× من قِبل السماء والأرض، ولم تلحظ أيّة جنبة أُخرى كمدّته، أو حصوله سابقاً، أو غير ذلك، بل كان نظرها متوجهاً إلى خصوص البكاء، وهذه من قَبيل: رواية إبراهيم النخعي، ورواية حنان بن سدير، وكثير بن شهاب، وميثم التمّار، وزرارة، وغيرها.
3 ـ إنّ مجموعة من الروايات صرّحت بأنّ البكاء لم يكن قد حصل سابقاً إلّا على يحيى بن زكريا، فلم تبكِ السماء ولا الأرض إلّا على يحيى بن زكريا والحسين×، وهذه الروايات عديدة، منها: رواية أبي بصير، وعبد الله بن هلال، ومحمد بن علي الحلبي، وعبد الخالق بن عبد ربّه، وجابر الجعفي، وكليب بن معاوية، وثبيت، والحسن بن زياد، وأبي سلمة، وإسماعيل بن كثير، وغيرها.
4 ـ إنّ بعض الروايات أوضحت أنّ معنى بكاء السماء هو حمرتها كما في: رواية الحسن بن زياد، وعبد الخالق بن عبد ربّه، وداوُد بن فرقد، وعبد الله بن هلال.
5 ـ إنّ بعض الروايات قيّدت مدّة البكاء بأربعين يوماً أو أربعين صباحاً، منها: رواية جابر الجعفي، وعبد الله بن هلال، وزرارة.
6 ـ إنّ بعض الروايات قيّدت مدّة البكاء بسنة كرواية داوُد بن فراقد.
7 ـ إنّ بعض الروايات أوضحت أنّ السماء بكت على الحسين× أربعين صباحاً بالدم، وإنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد، كرواية زرارة.
والخلاصة: إنّ هناك معطيات مختلفة من الروايات بعد اتفاقها على أصل البكاء، ولعلّه يُستشعر بوجود تعارض في بعضها؛ لذا من الضروري أنْ نرى مدى صحّة أو ضعف كلّ طائفة من هذه الطوائف، وهو ما سنتناوله فيما يأتي.
دراسة نماذج من الروايات التي تمثّل المعاني المتقدّمة
أوّلاً: ما يتعلّق بأصل قضية البكاء
أوضحنا فيما تقدّم أنّ جميع الروايات اتّفقت على موضوع البكاء، واختلفت في التفاصيل؛ لذا فكلّ ما ندرسه من روايات فيما يأتي إنّما يكون مشمولاً هنا، وبلا شكّ سيتّضح أنّ هناك عدّة كبيرة من الروايات الصحيحة والمعتبرة سنديّاً.
نعم، بعض الروايات اقتصرت على ذكر بكاء السماء ولم تذكر الأرض معها، وبعضها ذكر بكاء السماء والأرض.
أـ نماذج من الروايات المقتصرة على بكاء السماء
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني محمد بن جعفر الرزاز الكوفي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبد الله×، قال: لم تبكِ السماء إلّا على الحسين بن علي، ويحيى بن زكريا÷»[564].
فهذه الرواية اقتصرت على ذكر بكاء السماء فقط، ولم تذكر بكاء الأرض.
وسند هذه الرواية صحيح، رجالها كلّهم ثقات، فابن قولويه، وشيخه الرزاز، ومحمد بن الحسين كلّهم ثقات تقدّم ذكرهم غير مرّة، وجعفر بن بشير من الثقات الأجلّاء العبّاد[565]، وكليب بن معاوية فيه خلاف بسيط، غير أنّ الصحيح وثاقته[566].
كما أنّ ابن قولويه أخرج الخبر السابق في موضع آخر، بلفظ يزيد على سابقه، قال: «حدّثني أبي (رحمه الله تعالى)، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حمّاد، عن كليب بن معاوية، عن أبي عبد الله×، قال: كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زنا، وكان قاتل الحسين× ولد زنا، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما»[567].
وهنا كما هو واضح أيضاً اقتصر على ذكر السماء دون الأرض.
وهذا السند كسابقه، رجاله كلّهم ثقات إلّا أنّ جعفر بن بشير رواها هنا عن حمّاد، عن كليب، فإمّا أنْ يكون هناك اختلاف في السند وأنّ حمّاداً إمّا زِيد في هذا السند أو أُنقص من السند الأوّل، أو نقول: إنّ جعفر بن بشير قد سمعها تارةً من حمّاد، عن كليب، وتارةً من كليب مباشرةً، غير أنّ الأمر يسهل فيما إذا عرفنا أنّ حمّاداً الذي يكثر عنه جعفر بن بشير هو حمّاد بن عثمان وهو ثقة، ولو فرضنا أنّه عثمان بن عيسى، فهو ثقة أيضاً، وقد ذكر السيّد الخوئي أنّ الذي ورد بعنوان حمّاد مشترك بين ابن عيسى وابن عثمان، وقد وقع في إسناد كثير من الروايات تبلغ ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرين مورداً[568].
والخلاصة: إنّ الرواية بهذه الألفاظ صحيحة أيضاً.
وهناك طريق آخر ذكره ابن قولويه، قال: «حدّثني محمد بن الحسن، ومحمد بن أحمد بن الحسين جميعاً، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسن، عن فضالة بن أيوب، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبد الله× مثله»[569].
ولا نرى مبرراً لدراسة سندها مادامت متّحدة مع سابقتها في اللفظ.
أخرجه ابن قولويه، قال: «وحدّثني علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن إبراهيم، وسعد بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر×، قال: ما بكت السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلّا على الحسين بن علي÷، فإنّها بكت عليه أربعين يوماً»[570].
وهذه الرواية أيضاً اقتصرت على ذكر السماء فقط.
وهذا السند رجاله كلّهم ثقات معروفين، فابن قولويه وشيخه الصدوق الأب من الثقات المعروفين، وعلي بن إبراهيم القمّي، وسعد بن عبد الله الأشعري من الثقات الأجلّاء أيضاً، وإبراهيم بن هاشم تقدّم غير مرّة أنّه ثقة، وأمّا علي بن فضّال، فالظاهر أنّه تحريف وأنّ النص هو (ابن فضّال)؛ لأنّ إبراهيم بن هاشم إنّما يروي عن الحسن بن علي بن فضّال، وأمّا علي بن الحسن بن فضّال، فهو يروي عن إبراهيم بن هاشم لا العكس، وكيفما كان فكلاهما ثقة، فالحسن بن علي بن فضّال، ثقة من الأجلّاء، كان فطحياً، ثمّ رجع إلى القول الحق[571].
وعلي بن الحسن، ثقة جليل القدر[572].
وأمّا المفضّل بن صالح فقد وقع الخلاف فيه، وقد مال الوحيد إلى توثيقه بقرينة رواية الأجلّاء عنه، وكذلك أصحاب الإجماع وغير ذلك من القرائن[573].
ولابن قوليه فيه طريقان، يختلفان في بعض الألفاظ:
الأوّل: قال ابن قولويه: «وحدّثني محمد بن جعفر الرزاز القرشي، قال: حدّثني محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن صفوان بن يحيى، عن داوُد بن فرقد، عن أبي عبد الله×، قال: احمرّت السماء حين قُتل الحسين× سنة، ويحيى بن زكريا، وحمرتها بكاؤها»[574].
فهذا الخبر اقتصر على ذكر بكاء السماء، ولم يتطرّق لذكر الأرض كما هو واضح.
وأمّا السند فهو صحيح، رجاله إمامية ثقات، فابن قولويه، والرزاز، ومحمد بن الحسين كلّهم ثقات تقدّم ذكرهم.
وصفوان بن يحيى، من الثقات الأجلّاء العبّاد[575].
وداوُد بن فرقد ثقة أيضاً[576].
الثاني: قال ابن قولويه أيضاً: «حدّثني أبي، عن محمد بن الحسن بن مهزيار، عن أبيه، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن داوُد بن فرقد، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: كان الذي قتل الحسين بن علي÷ ولد زنا، والذي قتل يحيى بن زكريا ولد زنا، وقال: احمرّت السماء حين قُتل الحسين بن علي سنة، ثمّ قال: بكت السماء والأرض على الحسين بن علي، وعلى يحيى بن زكريا، وحمرتها بكاؤها»[577].
وأمّا هذا الطريق: فابن قولويه وأبوه ثقات كما تقدّم، ومحمد بن الحسن بن مهزيار، فهو أيضاً ثقة من مشايخ ابن قولويه، لكن أبوه الحسن بن مهزيار لم يذكروه، وعلي بن مهزيار ثقة[578]، والحسن بن سعيد الأهوازي ثقة[579]، ويرى السيّد الخوئي أنّ علي بن مهزيار يروي عن الحسين بن سعيد لا عن الحسن كما أنّ الذي يروي عن فضالة بكثرة هو الحسين لا الحسن، وعدم ثبوت رواية الحسن عنه[580]، وكيفما كان فالحسين والحسن كلاهما من الثقات.
وفضالة بن أيوب ثقة أيضاً[581].
فتلخّص أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة الحسن بن مهزيار، وهو متّفق مع الطريق المتقدّم في أصل مسألة البكاء ويختلف عنه في بعض الجزئيات.
وهو أيضاً ذكر بكاء السماء ولم يتعرّض للأرض، وسيأتي ذكره لاحقاً، وهو معتبر من حيث السند أيضاً.
ب ـ دراسة نماذج من الروايات ذكرت بكاء السماء والأرض
وكما دلّت الأخبار على بكاء السماء، فقد دلّت أخبار أُخرى على بكاء السماء والأرض، منها: خبر أبي بصير، وخبر حنان بن سدير، وخبر الحسين بن ثوير وغيرها، وهذه الأخبار الثلاثة كلّها معتبرة سنداً:
أخرجه ابن قولويه، قال: «وحدّثني محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص النحاس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله×، قال: إنّ الحسين× بكى لقتله السماء والأرض واحمرّتا، ولم تبكيا على أحد قطُّ إلّا على يحيى بن زكريا، والحسين بن علي÷»[582].
وقال ابن قولويه أيضاً: «وحدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بإسناده مثله»[583].
فهذا الخبر صرّح بأنّ السماء والأرض بكتا على الحسين× ولم يقتصر على ذكر السماء.
وأمّا من حيث السند فهو معتبر.
فمحمّد بن جعفر الرزاز، هو شيخ ابن قولويه، وشيخ الكليني، وقد أكثر عنه، ومن مشايخ الشيعة، فلا إشكال في وثاقتة[584]، وكذا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، فإنّه من الأجلّاء الثقات[585].
والشيخ ابن قولويه لم يقتصر في طريقه إلى الحسين على شيخه الرزاز، بل حدّث عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، وكلاهما ثقات أيضاً، والغرض أنّ الطريق إلى وهيب صحيح، ووهيب بن حفص النحاس، فقد استظهر السيّد الخوئي أنّه الجريري بعينه، وكذلك التستري، والجريري ثقة[586].
وأبو بصير الأسدي ثقة إمامي من أصحاب الإجماع.
فتحصّل أنّ هذا السند رجاله كلّهم ثقات غير أنّ وهيب واقفي[587]، فيكون السند موثّق.
أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبي&، وعلي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن الفضل، عن حنان، قال: قلت لأبي عبد الله×: ما تقول في زيارة قبر أبي عبد الله الحسين×، فإنّه بلغنا عن بعضهم أنّها تعدل حجة وعمرة؟ قال: لا تعجب، ما أصابَ مَن يقول هذا كلّه، ولكن زره ولا تجفه، فإنّه سيّد الشهداء، وسيّد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والأرض»[588].
وهذا الخبر أيضاً صريح في بكاء السماء والأرض معاً.
لكنّ الخبر بهذا السند ضعيف؛ لجهالة موسى بن الفضل.
وقال ابن قولويه أيضاً: «حدّثني أبي، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله× مثله سواء»[589].
وأخرجه الحميري في قرب الإسناد، قال: «وعنهما [أي: محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد حسب ما تقدّما في أسانيده السابقة]، عن حنان بن سدير، قال: قلت لأبي عبد الله×: ما تقول في زيارة قبر الحسين×؟ فإنّه بلغنا عن بعضكم أنّه قال: تعدل حجّة وعمرة. قال: فقال: ما أضعف هذا الحديث، ما تعدل هذا كلّه، ولكن زوروه ولا تجفوه. فإنّه سيّد شباب الشهداء، وسيّد شباب أهل الجنّة، وشبيه يحيى بن زكريا، وعليهما بكت السماء والأرض»[590].
والخبر بهذا السند أيضاً صرّح ببكاء السماء والأرض، كما أنّه يمكن القول بصحّته؛ إذ إنّ رواته من الإمامية الثقات باستثناء عبد الصمد بن محمد الأشعري، فلم يرد فيه جرح ولا توثيق، لكن رواية الأجلّاء عنه، كمحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن علي بن محبوب، قد توجب القول بوثاقته.
كما أنّ عبد الصمد لم ينفرد، بل تابعه محمد بن عبد الحميد، وهو الآخر فيه كلام بين التوثيق والجهالة.
ولا نجد حاجة للبحث مفصّلاً؛ لأنّ السند القادم هو سند صحيح.
فقد قال ابن قولويه أيضاً: «حدّثني أبي (رحمه الله تعالى)، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله× مثله»[591].
وهذا السند معتبر، رجاله كلّهم من الثقات، فابن قولويه وأبوه، وجماعة مشايخه، وسعد بن عبد الله الأشعري، وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، كلّهم ثقات معروفون.
ومحمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة أيضاً[592].
وأمّا حنان بن سدير، فهو واقفي ثقة أيضاً[593].
فالسند حينئذٍ موثّق.
وهو خبر معتبر سيأتي لاحقاً، وقد نصّ على أنّ السموات السبع والأرضين السبع كلّها بكت على الحسين×.
ثانياً: ما دلّ على البكاء مطلقاً من دون لحاظ جهات أُخرى
ومن الواضح من خلال التخريج أنّ هناك عدّة أخبار قد تناولت مسألة البكاء بصورة مطلقة، فلم تقيّدها بوقت محدّد، ولم تبيّن نوع البكاء، ولم تُشر إلى أيّ خصوصية أُخرى، فقد اقتصرت على البكاء فقط، ومن هذه الأخبار:
وقد تقدّم ذكره ودراسته بطرقه المختلفة، وعرفنا أنّ الخبر معتبر، وقد نصّ الخبر على أهمية زيارة الحسين× وأنّه شبيه يحيى بن زكريا: «وعليهما بكت السماء والأرض»[594].
تقدّم في أثناء التخريج أنّ طريقين لهذا الخبر ضعيفان، لكن الخبر ورد بطريق آخر صحيح معتبر، وهو ما أخرجه ابن قولويه أيضاً، قال: «حدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان، والمفضّل بن عمر، وأبو سلمة السراج جلوساً عند أبي عبد الله×، فكان المتكلّم يونس ـ وكان أكبرنا سناً ـ وذكر حديثاً طويلاً، يقول: ثمّ قال أبو عبد الله×: إنّ أبا عبد الله× لمّا مضى، بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن، وما ينقلب في الجنّة والنار من خلق ربنا، وما يُرى وما لا يُرى بكى على أبي عبد الله إلّا ثلاثة أشياء لم تبكِ عليه. قلت: جُعلت فداك، ما هذه الثلاثة الأشياء؟ قال: لم تبكِ عليه البصرة، ولا دمشق، ولا آل عثمان بن عفان، وذكر الحديث»[595].
وأخرجه الكليني في الكافي، عن: «عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس بن ظبيان، والمفضّل بن عمرو أبو سلمة السراج، جلوساً عند أبي عبد الله× وكان المتكلّم منّا يونس، وكان أكبرنا سنّاً...»[596]. وذكر حديثاً مفصّلاً من جملته ما ذكره ابن قولويه فيما تقدّم.
فهذا الخبر تحدّث عن جنبة البكاء ولم يلحظ جهات أُخرى كمدّته، أو نوعه، أو تقييده بأشخاص معينين وما شاكل، بل كان ناظراً فقط إلى جنبة البكاء.
وأمّا من حيث السند، فهو صحيح معتبر، رجاله إمامية ثقات؛ إذ لا كلام في وثاقة رجال السند إلى القاسم بن يحيى، وأمّا هو أعني القاسم بن يحيى، فثقة أيضاً؛ لقرائن عدّة ذكرها الوحيد كرواية الأجلّة عنه، وكثرة رواياته والإفتاء بمضمونها، وعدم طعن أحد من علماء الرجال فيه[597].
كما وثّقه السيّد الخوئي اعتماداً على الشيخ الصدوق؛ حيث عدّ أحد الروايات الواردة في الزيارة والتي جاء القاسم في سندها بأنّها أصحّ الزيارات عنده من طريق الرواية[598]. وجدّه الحسن بن راشد مولى بني العباس، فيه كلام، لكن الوحيد قوّى أمره وتبعه على ذلك المامقاني[599]. ووثّقه السيّد الخوئي طبق مبناه القاضي بوثاقة رجال تفسير القمي[600]. كما أنّه جاء في سند الرواية التي قال عنها الشيخ الصدوق بأنّها أصح الزيارات عنده من طريق الرواية[601]. والحسين بن ثور ثقة أيضاً[602].
فتبيّن أنّ هذا الحديث صحيح معتبر أيضاً.
كما أخرجه الشيخ الطوسي في الأمالي، قال: «حدّثنا أبو عبد الله محمد بن محمد، قال: حدّثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد&، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن أبي فاختة، قال: كنت أنا، وأبو سلمة السراج، ويونس بن يعقوب، والفضيل بن يسار عند أبي عبد الله جعفر بن محمد÷، فقلت له: جُعلت فداك، إنّي أحضر مجالس هؤلاء القوم... وقال: إنّ أبا عبد الله الحسين× لمّا قُتل بكت عليه السماوات السبع والأرضون السبع، وما فيهن وما بينهن، ومَن يتقلّب في الجنّة والنار، وما يُرى وما لا يُرى، إلّا ثلاثة أشياء، فإنّها لم تبكِ عليه. فقلت: جُعلت فداك، وما هذه الثلاثة أشياء التي لم تبكِ عليه؟ فقال: البصرة، ودمشق، وآل الحكم بن أبي العاص»[603].
وهذا السند صحيح، رجاله كلّهم إمامية ثقات، فشيخ الطوسي هو الشيخ المفيد، وشيخه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فيه خلاف، لكن قال بوثاقته الكثير كالعلّامة، والشهيد الثاني، وغيرهم، وقد ترجمه المامقاني مفصّلاً وانتهى إلى وثاقته[604]. وبقيّة الرجال كلّهم من المعروفين الثقات.
ثالثاً: إنّ السماء والأرض لم تبكِ إلّا على الحسين، ويحيى بن زكريا
وفي المقام أكثر من عشرة روايات ـ وفيها المعتبرة ـ أكّدت على أنّ حادثة البكاء اقتصرت على يحيى بن زكريا، والحسين بن علي×، ولم تحصل لغيرهما، فمن هذه الروايات: رواية عبد الله بن هلال، وأبي بصير، ومحمد بن عبد الله الحلبي، وعبد الخالق بن عبد ربّه، وكليب بن معاوية، وغيرها ممّا هو واضح في التخريج، وسنقتصر هنا من باب الإشارة على ذكر اثنين فقط:
وهذه الرواية تقدّمت، وعرفنا أنّها معتبرة سنداً، وقد جاء فيها ما نصّه: «ولم تبكيا على أحد قطُّ إلّا على يحيى بن زكريا، والحسين بن علي÷»[605].
وهذه الرواية أخرجها ابن قولويه، قال: «حدّثني علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله×، في قوله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)، قال: لم تبكِ السماء على أحد منذُ قُتل يحيى بن زكريا حتى قُتل الحسين×، فبكت عليه»[606].
ورواها الراوندي من طريق الصدوق كما تقدّم.
فهذه الرواية أيضاً صريحة في أنّ السماء لم تبكِ على أحد سوى يحيى بن زكريا، والحسين بن علي×.
وأمّا من حيث السند، فهو صحيح رجاله كلّهم إمامية ثقات، فابن قولويه، وشيخه الصدوق الأب، وعلي بن إبراهيم، وأبوه، كلّهم ثقات.
وابن فضّال يُطلق على جماعة كلّهم ثقات، قال السيّد الخوئي: «إن ابن فضّال يُطلق على الحسن بن علي بن فضّال، وعلى أبنائه، علي، وأحمد، ومحمد، والمشهور منهم الحسن وابنه علي»[607].
فالحسن بن علي بن فضّال، ثقة من الأجلّاء، كان فطحياً، ثمّ رجع إلى القول الحق[608].
وعلي بن الحسن، ثقة جليل القدر[609].
وأحمد ثقة، ويقال كان فطحياً[610].
ومحمد لا يبعد كونه ثقة أيضاً[611].
على أنّه لا يبعد أنْ يكون الوارد في السند هو الحسن بن علي بن فضّال؛ لرواية إبراهيم بن هاشم عنه.
وأبو جميلة، هو مفضّل بن صالح، وفيه خلاف، وقد مال الوحيد إلى توثيقه بقرينة رواية الأجلّاء عنه، وكذلك أصحاب الإجماع، وغير ذلك من القرائن[612].
ومحمد بن علي الحلبي من الثقات الأجلّاء[613].
رابعاً: إنّ معنى البكاء هو حمرة السماء
وهنا توجد عدّة من الروايات، منها:
وقد تقدّم أنّ لابن قوليه فيه طريقان يختلفان في بعض الألفاظ، وكلاهما نصّا على أنّ السماء احمرّت حين قُتل الحسين×، ويحيى بن زكريا، وحمرتها بكاؤها.
وعرفنا أنّ الطريق الأوّل، صحيح من حيث السند، رجاله إمامية ثقات.
وأمّا الطريق الثاني، فهو ضعيف؛ لجهالة الحسن بن مهزيار.
2 ـ خبر عبد الخالق بن عبد ربّه
أخرجه ابن قولويه، قال: «وحدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن عبد الخالق بن عبد ربّه، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: لم يجعل له من قَبلُ سميّا، الحسين بن علي لم يكن له من قَبلُ سميّا، ويحيى بن زكريا× لم يكن له من قَبلُ سميّا، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً. قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء»[614].
فالخبر يصرّح بأنّ السماء تطلع حمراء وتغرب حمراء، في إشارة إلى أنّ السماء محمرّة من حين شروق الشمس إلى حين غروبها.
وأمّا من حيث السند، فهو معتبر، رجاله كلّهم ثقات، فابن قولويه، وأبوه، وسعد بن عبد الله، وأحمد بن محمد بن عيسى، كلّهم من الثقات.
والحسن بن علي بن فضّال، ثقة من الأجلّاء، كان فطحياً، ثمّ رجع إلى القول الحق[615].
وعبد الله بن بكير هذا، هو عبد الله بن بكير بن أعين، فطحي لكنّه ثقة، له ترجمة مفصّلة في معجم رجال الحديث[616].
وزرارة بن أعين، ثقة من الأجلّاء.
وعبد الخالق بن عبد ربّه، ثقة أيضاً[617].
فالسند موثّق.
وأورد السيّد شرف الدين الأسترابادي، وكذلك السيّد هاشم البحراني هذا الحديث عن القمّي، علي بن إبراهيم، «عن أبيه، عن محمد بن خالد، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد الله ـ× ـ يقول في قول الله (عزّ وجلّ): (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا)، فقال الحسين× لم يكن له من قَبلُ سميّا، ويحيى بن زكريا لم يكن له من قَبلُ سميّا، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً. قلت: فما [كان] بكاؤها؟ قال: كانت الشمس تطلع حمراء وتغيب حمراء»[618].
والخبر بهذا السند لا يختلف عن سابقه من حيث الدلالة؛ لذا فالكلام في ثبوت أو عدم ثبوت تفسير القمّي لا يجدي كثير نفع، إلّا أنّه على القول بثبوت التفسير ووثاقة جميع رجاله، وكذا على القول بثبوت قسم من التفسير لعلي بن إبراهيم ووثاقة رجاله أيضاً، فإنّ ذلك يُعطي قوّة أكثر للرواية.
إلّا أنّه بعد البحث والتنقيب لم نعثر على هذه الرواية في تفسير القمّي، فلعلّها ساقطة من النُّسخ الواصلة إلينا.
وقد ذكر السيّد شرف الدين الأسترابادي، وجهاً آخر للخبر، مضافاً لطريق القمّي المتقدّم،، فقال بعد ذكره الآية الشريفة:
تأويله: قال محمد بن العباس&: قال: «حدّثنا حميد بن زياد، عن أحمد بن الحسين بن بكر، قال: حدّثنا الحسن بن علي بن فضّال بإسناده إلى عبد الخالق، قال: سمعت أبا عبد الله ـ × ـ يقول في قول الله (عزّ وجلّ) (لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا)، قال: ذلك يحيى بن زكريا ـ ÷ ـ لم يكن له من قَبلُ سميّا، وكذلك الحسين ـ× ـ لم يكن له من قَبلُ سميّا، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً. قلت: فما كان بكاؤها؟ قال: تطلع الشمس حمراء»[619].
والخبر هذا مبتلى بالإرسال، فلم يذكر سند ابن فضّال إلى عبد الخالق، ولعلّه نفس السند السابق، كما أنّ السيّد شرف الدين متوفّى في سنة (965هـ)، وهو ينقل من كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت لمحمد بن العباس، وثبوت النُّسخة التي عثر عليها السيّد شرف الدين وأكثر من النقل عنها يحتاج إلى تحقيق، فإنّها لم تصل إلينا.
وكيف ما كان، فإنّ الخبر بسنده الذي نقله ابن قولويه هو سند معتبر موثّق.
خامساً: إنّ مدّة البكاء كانت أربعين يوماً، أو أربعين صباحاً
ويدلّ عليه خبر جابر الجعفي، وعبد الخالق بن عبد ربّه، وعبد الله بن هلال، وخبر زرارة بن أعين، وسنقتصر هنا من باب الإشارة على ذكر خبرين.
أخرجه ابن قولويه، قال: «وحدّثني علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن إبراهيم، وسعد بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم بن هاشم، عن علي بن فضّال، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر×، قال: ما بكت السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلّا على الحسين بن علي÷، فإنّها بكت عليه أربعين يوماً»[620].
فهو صريح في أنّ البكاء كان أربعين يوماً.
وأمّا من حيث السند، فرجاله كلّهم ثقات باستثناء المفضّل بن صالح (أبي جميلة)، فقد وقع الخلاف فيه، وقد مال الوحيد إلى توثيقه بقرينة رواية الأجلّاء عنه، وكذلك أصحاب الإجماع، وغير ذلك من القرائن[621].
2 ـ خبر عبد الخالق بن عبد ربّه
وقد تقدّم فيما سبق وجاء فيه: «ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً...»
وعرفنا أنّ سنده معتبر (موثّق).
سادساً: إنّ السماء بكت سنة على الحسين ×
ويدلّ عليه: خبر داوُد بن فرقد فقد جاء فيه: « احمرّت السماء حين قُتل الحسين× سنة...»
وقد تقدّمت دراسته وتبيّن أنّه صحيح.
سابعاً: إنّ السماء بكت أربعين يوماً بالدم والأرض بالسواد
ويدلّ عليه: خبر زرارة والذي جاء فيه: «يا زرارة، إنّ السماء بكت على الحسين أربعين صباحاً بالدم، وإنّ الأرض بكت أربعين صباحاً بالسواد...»[622].
لكنّ هذا الخبر ضعيف من حيث السند؛ ويكفي في ذلك جهالة علي بن محمد بن سالم، وجهالة عبد الله بن حمّاد البصري.
وكذلك ضعف عبد الله بن عبد الرحمن الأصم على ما قدّمناه سابقاً.
النتائج التي نخلص إليها من خلال الروايات المعتبرة
اتّضح أنّ للروايات الواردة في البكاء على الحسين× معطيات متعدّدة، وأنّ بعضها قد يشم منها رائحة التعارض؛ لذا سنتعرّض للنتائج النهائية التي يمكن أنْ نصل إليها من خلال النظر الجمعي لتلك الروايات:
1 ـ لا شكّ ولا شبهة في أنّ السماء والأرض بكتا على الحسين×، وقد دلّت كلّ الروايات المتقدّمة بمختلف ألسنتها على ذلك، سوى أنّ بعضها قصر البكاء على السماء دون ذكر الأرض، وبعضها الآخر ذكر بكاء السماء والأرض، وعلى كلا الأمرين دلّت الروايات المعتبرة.
وحيث إنّ الروايات بكلا طائفتيها بصدد إثبات الموضوع، فلا تعارض بينهما، فإثبات الشيء لا ينفي ما سواه، أي: إنّ الروايات الدالة على بكاء السماء لا تنفي حصول البكاء من الأرض وغيرها، فهي ساكتة عن تلك الجهة، فإذا وردت روايات تؤكّد بكاء الأرض، أو الشمس، أو الكواكب، ثبت ذلك حينئذٍ، والحال أنّ الروايات المعتبرة المعتضدّة مع روايات أُخرى لم تبلغ درجة الاعتبار دلّت على بكاء السماء والأرض كما عرفنا.
فالخلاصة: إنّ أصل مسألة بكاء السماء والأرض دلّت عليها مجموعة كبيرة من الروايات بما فيها المعتبر سنداً.
2 ـ إنّ السماء والأرض لم تبكيا إلّا على الحسين بن علي×، ويحيى بن زكريا×، وهذا المعنى أيضاً ورد في روايات عديدة بعضها معتبرة سنداً، وهي لا تتنافى مع الروايات المثبتة لأصل البكاء من دون نظر إلى حصوله على غير الحسين أو عدمه، فكلاهما يتّفقان على حصول البكاء على الحسين، غير أنّ هذه الطائفة تبيّن أنّ ظاهرة البكاء لم تحصل إلّا على الحسين×، ومن قَبله يحيى بن زكريا×، فلا مانع من التمسّك بهذا البيان الذي ورد فيها.
3 ـ يستفاد من مجموعة من الروايات أنّ أحد مصاديق البكاء هو حمرة السماء، فقد ورد أنّ «حمرتها بكاؤها»، «وبكى لقتله السماء والأرض واحمرّتا»، وهذان الخبران معتبران، كما ورد أنّهم: «مكثوا أربعين يوماً تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة... فذاك بكاؤهما»، لكن هذه الرواية ضعيفة السند، وورد نحوها بسند معتبر جاء فيه: «ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً. قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء».
و في رواية ضعيفة أُخرى ورد: «تطلع الشمس في حمرة وتغيب في حمرة».
والغرض أنّ هذه الروايات أوضحت مصداقاً من مصاديق بكاء السماء والأرض، وهو الاحمرار سواء في السماء أو في الأرض.
أمّا رواية زرارة التي ورد فيها أنّ السماء بكته أربعين يوماً بالدم، والأرض أربعين يوماً بالسواد، فهي ضعيفة، إلا أنّها غير متنافية مع تلك؛ إذ إنّ الحمرة كما قلنا هي مصداق من مصاديق البكاء، فليكن الدم في السماء والاسوداد في الأرض يمثّل مصداقاً آخر، وسيأتي أنّ هناك مصاديق أُخرى يمكن أنْ تمثّل حالة البكاء.
4 ـ دلّت أربع أخبار بما فيها اثنان معتبران، على أنّ البكاء كان أربعين يوماً، في حين دلّت رواية واحدة معتبرة على أنّ البكاء كان سنة، واكتفت بقيّة الروايات بالتصريح بحدوث أصل البكاء ولم تنظر إلى مدّته.
فالمقدار المتيقّن من حصول البكاء حينئذٍ هو أربعون يوماً، خصوصاً أنّ الرواية التي ذكرت سنة هي تتفق مع البقيّة في حصوله أربعين يوماً.
على أنّه يمكن حمل الاختلاف على اختلاف الإماكن، فيكون البكاء في مكان ما استمر لسنة كاملة، وفي أماكن أخرى استمر لأربعين يوماً، والله العالم.
تخريج ودراسة الأخبار الدالّة على الحادثة من مصادر أهل السنّة
أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر
1 ـ إبراهيم النخعي.
2 ـ يزيد بن أبي زياد.
3 ـ قرة بن خالد.
4 ـ السدي.
5 ـ ابن سيرين.
6 ـ أصبغ بن نباتة، عن علي×.
7 ـ الربيع بن خيثم.
ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سنديّاً
قال ابن أبي حاتم: «حدّثنا علي بن الحسين، حدّثنا عبد السلام بن عاصم، حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا المستورد بن سابق، عن عبيد المكتب، عن إبراهيم (رضي الله عنه)، قال: ما بكت السماء منذُ كانت الدنيا إلّا على اثنين. قيل لعبيد: أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه وحيث يصعد عمله. قال: وتدري ما بكاء السماء؟ قال: لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان، إنّ يحيى بن زكريا لمّا قُتل احمرّت السماء وقطرت دماً، وإنّ حسين بن علي يوم قُتل احمرّت السماء»[623].
علي بن الحسين الدرهمي ثقة[624].
وعبد السلام بن عاصم، قال فيه الهيثمي: «ثقة»[625]. وقال محررا التقريب: شعيب الأرنؤوط، وبشّار عوّاد: «صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع من الثقات. وقال أبو حاتم: شيخ»[626].
وإسحاق بن إسماعيل الرازي، صدوق حسن الحديث، قال فيه ابن معين: «أرجو أنْ يكون صدوقاً»[627]. وذكره ابن حبّان في الثقات[628].
وأمّا المستورد بن سابق، فقد ذكره البخاري في تاريخه بعنوان: مستورد بن سابط، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال فيه: «سمع عبيد المكتب، كوفي، روى عنه يحيي بن يحيي»[629].
وذكره ابن أبي حاتم بعنوان: مستورد بن سابق، وقال: «مستورد بن سابق الغزال، ويقال العصاب، روى عن عبيد المكتب، روى عنه يحيى بن يحيى، وصالح بن عبد الله الترمذي، وعلى بن الحسن الرازي المعروف بالكراع، سمعت أبي يقول ذلك: نا عبد الرحمن، قال: سألت أبى عنه، فقال: هو شيخ»[630].
فالرجل إذن ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يوردا فيه جرحاً، وهذه قرينة الوثاقة عند طائفة، أضف إلى ذلك فقد روى عنه جماعة من الثقات، وقال عنه أبو حاتم: شيخ. فالرجل صدوق حسن الحديث في أقلّ حالاته.
وقد ذكر الألباني أنّ رواية ثلاثة من الثقات عن الرجل الذي لم يجرح كافٍ في توثيقه[631].
وأمّا عبيد المكتب، فهو عبيد بن مهران المكتب، من رجال مسلم، ثقة لا كلام فيه، قال يحيى بن معين: «ثقة»[632]. وقال أبو حاتم: «ثقة صالح الحديث»[633].
وكذلك وثّقه النسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، وابن سعد، وذكره ابن حبّان في الثقات[634].
وإبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من رجال البخاري، ومسلم، والأربعة، وهو: فقيه ثقة كما قال ابن حجر[635]. وكان عجباً في الورع والخير، متوقّياً للشهرة، رأساً في العلم كما قال الذهبي[636].
تحصّل أنّ هذا الخبر جيد الإسناد لا شائبة فيه.
أورده ابن كثير، قال: «قال ابن أبي حاتم: وحدّثنا علي بن الحسين، حدّثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدّثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما) احمرّت آفاق السماء أربعة أشهر، قال يزيد: واحمرارها بكاؤها»[637].
وأورده القرطبي[638]، والماوردي[639].
علي بن الحسين الدرهمي ثقة[640].
ومحمد بن عمرو زنيج ثقة أيضاً، من رجال مسلم، وأبي داوُد، وابن ماجة، وثّقه أبو حاتم، وذكره ابن حبّان في الثقات، وروى عنه جملة من كبار الحفّاظ وأهل الحديث[641]. وقد صرّح بوثاقته الذهبي[642] وابن حجر[643].
وجرير بن عبد الحميد، من الثقات المعروفين، حتّى صرّح بعضهم بأنّه مجمع على ثقته[644].
ويزيد بن أبي زياد ثقة، وتكلّموا فيه من أجل حفظه، فبعضهم قال: ساء وتغيّر في آخره. وبعضهم قال: إنّه صدوق لكنّه كان يغلط. غير أنّ بعضهم رفض هذا الكلام فيه، فقال أحمد بن صالح المصري: «ثقة، ولا يعجبني قول مَن تكلّم فيه»[645]. وقال يعقوب بن سفيان: «وإنْ كان قد تكلّم الناس فيه لتغيّره في آخر عمره، فهو على العدالة والثقة، وإنْ لم يكن مثل منصور، والحكم، والأعمش، فهو مقبول القول ثقة»[646].
والخلاصة: إنّ الرجل ثقة في نفسه، أو لا أقل من كونه صدوقاً، وأكثر الكلام فيه إنّما لأجل تغيّره؛ لذا قال ابن حبّان: «وكان يزيد صدوقاً إلّا أنّه لمّا كبر ساء حفظه وتغيّر، فكان يتلقّن ما لُقن، فوقع المناكير في حديثه من تلقين غيره إيّاه، وإجابته فيما ليس من حديثه لسوء حفظه، فسماع مَن سمع منه قبل دخوله الكوفة في أوّل عمره سماع صحيح، وسماع مَن سمع منه في آخر قدومه الكوفة بعد تغيّر حفظه وتلقّنه ما يُلقّن سماع ليس بشيء»[647].
وانتهى الذهبي إلى أنّه: «شيعي عالم، فهم صدوق، رديء الحفظ، لم يُترك»[648].
فالرجل إنْ قلنا بوثاقته على ما ذهب إليه أحمد بن صالح، ويعقوب الفسوي، مع معرفتهما بالكلام فيه من غيرهم، فالخبر مقبول جيد لا شائبة فيه.
وإنْ قلنا: إنّ الرجل فيه كلام من قِبل حفظه، فإذا ما لاحظنا الحدث الذي ينقله، فهو عبارة عن حدث خطير ولافت للنظر، وظاهرة كونية واضحة المعالم، وهي عبارة عن احمرار آفاق السماء وبقائها مدّة على ذلك، فمثل هذه الحادثة لا يمكن أنْ تُنسى أو تُمحى من الذاكرة، حتّى يقال أنّه رديئ الحفظ، أو تغيّر بآخره، أو أنّه كان يُلقّن وما إلى ذلك، فهي ليست حديثاً سمعه من غيره، أو قصّة نُقلت له حتّى يمكن القول بتضعيفها، بل هو رأى أمراً بأُمّ عينيه ونقله كما هو، خصوصاً أنّه لم ينفرد بنقله، بل نقله غيره أيضاً، فيكون الخبر مقبولاً.
وبعد برهة من الزمن على كلامنا الآنف عن يزيد، وجدنا كلاماً للشيخ الألباني يؤيّد ما ذهبنا إليه، قاله في عبد الله بن سلمة الذي تغيّر حفظه؛ إذ حسّن سنداً جاء فيه عبد الله هذا، وعلّق قائلاً: «وفي عبد الله بن سلمة ضعف من قِبل أنّه كان تغيّر حفظه، لكنه هنا يروي أمراً شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنّه لا ينساه الراوي وإنْ كان فيه ضعف، بخلاف ما إذا كان يروي أمراً لم يشاهده كحديث عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، فإنّه يخشى عليه أنْ يزيد فيه أو ينقص منه، وأنْ يكون موقوفاً في الأصل تخونه ذاكرته فيرفعه»[649].
هذا الخبر يُمكن عدّه من الأخبار الجيّدة الحسنة في المقام.
أخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو غالب بن البنّا، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون، نا محمد بن إسماعيل بن العباس الورّاق إملاءً، نا إسحاق بن محمد بن مروان، نا أبي، نا إسحاق بن يزيد، عن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن قرّة، قال: ما بكت السماء على أحد إلّا على يحيى بن زكريا، والحسين بن علي، وحمرتها بكاؤها»[650].
وأورده السيوطي في الدر المنثور [651]، والقرطبي في تفسيره[652].
أبو غالب بن البنّا، شيخ ابن عساكر، وابن الجوزي، وغيرهم، وثّقه ابن الجوزي. وقال فيه الذهبي: «شيخ صالح، كثير الرواية، عالي السند»[653].
ومحمد بن أحمد بن محمد بن حسنون، قال فيه الخطيب: «كتبنا عنه وكان صدوقاً ثقة من أهل القرآن، حسن الاعتقاد»[654].
و محمد بن إسماعيل بن العباس الورّاق، محدّث ثقة[655].
وإسحاق بن محمد بن مروان، لم يرد فيه جرح مفسّر، فغاية ما ذكروا فيه، أنّ الدارقطني قال فيه وفي أخيه جعفر: «جعفر وإسحاق ابنا محمد بن مروان القطان الكوفي ليسا ممّن يُحتجّ بحديثهما»[656]. وأنّ أبا الحسين محمد الحجاجي سُئل عنه، فقال: «كانوا يتكلّمون فيه»[657].
والجرح غير المفسّر لا يُعتدّ به حسب المشهور، وحينئذٍ وبملاحظة كثرة تلاميذ الراوي، مع وجود عدد كبير من الثقات والحفّاظ الذين رووا عنه، منهم: محمد بن حبّان البستي، ومحمد بن المظفر البزاز، ومحمد بن العباس (أبو عمر بن حيويه)، وعلي بن محمد بن عبيد البزاز، وعلي بن عمر الحربي، وعبد الله بن محمد (أبو الشيخ الأصفهاني)، وغيرهم كثير، فلا يبعد القول حينئذٍ أنّ الرجل حسن الحديث.
وأمّا أبوه محمد بن مروان، فقد قال البرقاني، عن الدارقطني: «شيخ من الشيعة، حاطب ليل، متروك، لا يكاد يُحدّث عن ثقة»[658].
وما دام الدارقطني يراه شيخ من الشيعة، فلا غرابة في أنْ يكون متروكاً وحاطب ليل، في حين لم يستطع الدارقطني أنْ يجرحه بأمر واضح، فكونه حاطب ليل لا يعني أنّه ضعيف في نفسه، بل الأمر يتعلّق برواياته، وأنّه يروي كلّ ما يحصل عليه، وهناك جملة من كبار علماء السنة وُصِفوا بـ (حاطب ليل) كالسيوطي مع جلالة قدره ووثاقته.
وأمّا كونه لا يكاد يروي عن الثقات، فهذا أيضاً ليس بعلّة قادحة في الراوي نفسه، مع أنّه روى عن عدّة بين صدوق وثقة، فقد روى عن خلف بن أيوب وهو ثقة، وروى عن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وأمره يدور بين الثقة والصدوق، وروى عن عثمان بن سعيد بن كثير وهو ثقة أيضاً، وروى عن إبراهيم بن عبيد بن الطنافسي وهو ثقة، وروى عن مخلّد بن خداش وهو صدوق، وروى عن عياش بن عبد الله وهو ثقة، ذكره ابن حبّان في الثقات، وروى عنه شعبة وهو لا يروي إلّا عن ثقة، وروى عن سعيد بن عثمان البزاز وهو من الحفّاظ الثقات وهكذا، لربما يجد المتتبع كثيراً من الثقات الذين روى عنهم محمد بن مروان، ومعه يصبح كلام الداقطني ضعيفاً لا محلّ له، ومن الواضح أنّه أراد الحطّ منه لكونه شيعياً لا غير، والمشهور عدم دخالة العقيدة في تضعيف الراوي.
هذا، وقد روى عن محمد بن مروان عدّة من الرواة، منهم: ولده إسحاق، وولده جعفر، وعلي بن العباس بن الوليد وهو صدوق، وجعفر بن محمد الفزاري، فالرجل في الحقيقة لا يوجد فيه جرح واضح كما أنّه لم نقف له على تعديل، ولم يروِ عنه عدّة من الثقات حتّى نعدّه صدوقاً أو ثقة، فيبقى مجهول الحال، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ مجهول الحال احتجّ به جمع من أهل التحقيق، ولا أقل من كون حديثه يصلح للمعاضدة والتقوية.
وإسحاق بن يزيد، هو الكوفي الطائي، ثقة عند الشيعة، وذكره ابن أبي حاتم من دون جرح ولا تعديل، وقال: «إسحاق بن يزيد الكوفي، روى عن إبراهيم النخعي، وعبد الله بن نافع، عن الشعبي. روى عنه عبد الله بن رجاء الغداني البصري»[659].
وأمّا عبد الله بن مسلم، فقد ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «عبد الله بن مسلم بن يسار أدرك أنس بن مالك، روى عنه أهل البصرة»[660].
وذكره البخاري من دون جرح ولا تعديل[661].
وكذلك ذكره ابن أبي حاتم، وقال: «عبد الله بن مسلم بن يسار مولى بنى أُميّة البصري، روى عن أبيه، روى عنه ابن عون، وكهمس، والمبارك بن فضالة، والهيثم بن قيس العائشي، سمعت أبي يقول ذلك»[662].
فالرجل ثقة، خصوصاً وفق ما تقدّم من أنّ سكوت البخاري وابن أبي حاتم يُعدّ أمارة على التوثيق عند طائفة من العلماء.
وأمّا أبوه مسلم بن يسار، فقد نصّ على وثاقته عدّة من العلماء، وقال فيه ابن حجر: «ثقة عابد»[663].
وأمّا قرّة بن خالد، فهو ثقة ضابط متقن لا خلاف فيه[664].
والخلاصة: إنّ السند المذكور علّته الأساسية هو محمد بن مروان، وعرفنا أنّه مجهول الحال، وقد احتجّ بالمجهول جمع كبير من المحققين، مضافاً إلى أنّ الخبر يتعاضد مع بقيّة الأخبار الواردة في نفس الموضوع.
حيث ورد عنه أنّه قال: «لمّا قُتل الحسين بن علي بكت عليه السماء، وبكاؤها حمرتها»
وقد أرسله عنه عدّة من العلماء إرسال المسلّمات كابن كثير[665]، كالقرطبي[666]، والثعلبي[667]، والبغوي[668]، وسبط ابن الجوزي[669]، والزرندي الشافعي[670].
وإرسالهم له إرسال المسلّمات يُنبئ بثبوت القول له عندهم.
وقد عزاه ابن البطريق إلى مسلم في صحيحه، وذكر أنّه أورد رواية السدّي في أوّل الجزء الخامس في تفسير قوله سبحانه وتعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ)[671].
وقد تبع ابن البطريق على ذلك جماعة، فنسبوا الرواية لمسلم كالسيّد ابن طاووس[672]، والسيّد هاشم البحراني[673].
وأيضاً أخرجه الطبري، قال: «حدّثني محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حمّاد، عن الحكم بن ظهير، عن السُّدّي، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضوان الله عليهما) بكت السماء عليه، وبكاؤها حمرتها»[674].
أمّا محمد بن إسماعيل الأحمسي، فثقة، وثّقه النسائي، وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبّان في الثقات[675]، وانتهى الذهبي، وابن حجر إلى وثاقته[676].
وعبد الرحمن بن أبي حمّاد: هو عبد الرحمن بن شكيل أو (سكين)، المقرئ المعروف، قرأ على حمزة، وكان من أجلّة أصحابه، ثمّ قرأ على أبي بكر بن عياش[677]، ذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، فقال: «عبد الرحمن بن شكيل روى عن بسّام الصيرفي، وعمر بن ذر، روى عنه يوسف بن عدى، وقال أبو محمد: هو عبد الرحمن بن أبي حمّاد المقرئ الكوفي، روى عن شيبان النحوي، وفطر بن خليفة، وحمزة الزيات، وعيسى بن عمر، وهشيم، وابن المبارك، روى عنه أبو سعيد الأشج، وهارون بن حاتم، وإسحاق بن الحجاج الرازي الطاحوني، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي»[678].
وقال الذهبي: «قال أبو هشام الرفاعي: أقرأ مَن قرأ على حمزة أربعة: إبراهيم الأزرق، وخالد الكحال، وخلّاد الأحول، وكان عبد الرحمن بن أبي حمّاد أكبرهم وأعلمهم بعلم القرآن»[679].
وترجمه الخطيب وقال: «روى عنه يوسف بن عدي، وهارون بن حاتم، وعبد العزيز بن محمد بن ربيعة الكلابي، وعلي بن المثنى الطهوي، وأبو سعيد الأشج، وأحمد بن عبد الحميد الحارثي»[680].
وحدّث عنه أيضاً عثمان بن أبي شيبة[681]، والحسن بن جامع، ومحمد بن جنيد، ومحمد بن الهيثم[682]، وذكره ابن الجزري، وقال عنه: «صالح مشهور»[683].
وصحّح له الحاكم في المُستدرك[684].
وفي الجملة، فالرجل من القرّاء المعروفين، وذكره ابن أبي حاتم ولم يورد فيه جرحاً أو تعديلاً، وروى عنه جمع غفير من بينهم عدّة من الحفّاظ والثقات، مثل: أبي سعيد الأشج، ومحمد بن الهيثم، ويوسف بن عدي، والأحمسي، وأحمد الحارثي، فهو صدوق حسن الحديث طبق القواعد.
والحكم بن ظهير، اتّهموه بالرفض[685]، وأنّه كان يشتم الصحابة، كما أنّه روى: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه)، فكان طبيعياً أنْ يكون متّهماً ومتروكاً، فتعاقبت الكلمات في ذمّه وتضعيفه[686].
ولربّما لذلك ـ أي: لأنّ تضعيفه مبتنٍ على كونه رافضيّاً ـ نلاحظ أنّ عثمان ابن أبي شيبة قال فيه: «الحكم بن ظهير صدوق، وليس ممّن يُحتج به»[687].
بل قال ابن كثير: «وهو صاحب حديث حسن»[688].
والسُّدي: هو السُّدي الكبير، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، من رجال مسلم والأربعة، أحد علماء التفسير المعروفين، وثّقه عدّة من أئمة هذا الشأن، ونسبه بعضهم إلى التشيّع، وليّنه بعضهم، والجمع يقتضي أنّ أقلّ حالاته أنْ يكون صدوقاً حسن الحديث[689].
ولذا قال ابن حجر: «صدوق يهم، ورُميَ بالتشيع»[690].
وقال محررا التقريب (شعيب الأرنؤوط، وبشّار عوّاد): «صدوق، حسن الحديث، إمام في التفسير، ما نقم عليه سوى التشيّع، ومفهوم التشيّع في زمانه غير الذي عُرف فيما بعد، فهي علّة غير قادحة، وقد روى عنه أئمّة الناس: سفيان الثوري، وشعبة، وسليمان التيمي، وزائدة بن قدامة، وأبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وغيرهم، ووثّقه أحمد بن حنبل، والعجلي، وابن حبّان، وارتضاه يحيى بن سعيد القطان على تشدّده، فقال: لا بأس به، ما سمعت أحداً يذكره إلّا بخير، وما تركه أحد. وقال النسائي: لا بأس به. وغضب عبد الرحمن بن مهدي حينما ضعّفه يحيى بن معين، وكره ما قال...»[691].
يمكن القول أنّ سند هذا الخبر جيّد، فالحكم بن ظهير علّته الأساس هي التشيّع؛ ومن أجلها تركوه ورموه بالضعف، فيمكن أنْ يعوّل على خبره هنا خصوصاً عند ضمّه لغيره من بقيّة الأخبار.
أخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو عبد الله الخلال، أنا سعيد بن أحمد العيّار، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني، نا عمر بن الحسين بن علي بن مالك الشيباني القاضي، نا أحمد بن الحسن الخزاز، نا أبي، نا حصين بن مخارق، عن داوُد بن أبي هند، عن ابن سيرين، قال: لم تبكِ السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلّا على الحسين بن علي»[692].
ومن طريقه ابن العديم، قال: «أنبأنا أبو نصر بن هبة الله الشافعي، قال: أخبرنا الحافظ أبو القاسم، قال: أخبرنا أبو عبد الله الخلال، قال: أخبرنا سعيد بن أحمد العيار، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني، قال: حدّثنا عمر بن الحسين بن علي بن مالك الشيباني القاضي، قال: حدّثنا أحمد بن الحسن الخزاز، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا حصين بن مخارق، عن داوُد بن أبي هند، عن ابن سيرين، قال: لم تبكِ السماء على أحد بعد يحيى بن زكريا إلّا على الحسين بن علي»[693].
وأخرجه الكنجي الشافعي بنفس السند[694]، وأورده الذهبي في سيره[695].
أمّا أبو عبد الله الخلال، فهو الحسين بن عبد الملك بن الحسين، قال عنه الذهبي: «وكان ثقة صدوقاً، إماماً في العربية، كثير المحاسن»[696].
وأمّا سعيد بن أحمد العيّار، هو سعيد بن أبي سعيد، قال فيه الذهبي: «صدوق إنْ شاء الله تعالى»[697].
وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الجوزقي، شيخ نيسابور ومحدّثها، وثاقته معلومة[698].
وعمر بن الحسين (الحسن) بن علي بن مالك الشيباني القاضي، أحد الحفّاظ المعروفين، ضعّفه الدارقطني من دون ذكر السبب، والجرح لا يُقبل إلّا مفسّراً، ونُقل عنه أنّه قال: كان يكذب. إلّا أنّ الذهبي ذكر أنّه لم يصحّ عن الدارقطني ذلك[699]. وفي قبال ذلك أقوال بالتعديل، فقد حدّث في زمن إبراهيم الحربي، وقال الخطيب في ذلك: «تحديث ابن الأشناني في حياة إبراهيم الحربي، له فيه أعظم الفخر وأكبر الشرف، وفيه دليل على أنّه كان في أعين الناس عظيماً، ومحلّه كان عندهم جليلاً»[700]. وسئل عنه أبو علي الهروي، فقال: «إنّه صدوق». وقال أبو علي الحافظ: «ثقة»[701].
وقال طلحة بن محمد بن جعفر: «وهذا رجل من جلّة الناس، ومن أصحاب الحديث الموجودين، وأحد الحفّاظ له، وحسن المذاكرة بالأخبار، وكان قبل هذا يتولّى القضاء بنواحي الشام، ويستخلف الكفاة، ولم يخرج عن الحضرة، وتقلد الحسبة ببغداد، وقد حدّث حديثاً كثيراً، وحمل الناس عنه قديماً وحديثاً»[702].
فالرجل إذن ثقة، أو لا أقلّ من كونه صدوقاً حسن الحديث.
وأمّا أحمد بن الحسن الخزاز، فلم نجد مَن تعرّض له قدحاً أو مدحاً، وقد حدّث عنه أحمد بن محمد ابن عقدة الحافظ المشهور، وأحمد بن محمد بن سعيد بن مهران وهو ثقة، وعلي بن الحسين بن محمد الأصفهاني وهو صدوق، وعمر بن الحسن الأشناني المتقدّم وهو ثقة أو صدوق، فيُقبل حديثه حينئذٍ، ولو تنزلنا عن ذلك، فهو مجهول الحال ويُقبل حديثه على رأي أكثر المتقدّمين، ويُضعّف بضعف خفيف على رأي المتأخرين.
وأمّا أبوه الحسن بن سعيد، فقد روى عنه جمع، وأقل حالاته مجهول الحال كولده المتقدّم.
أمّا حصين بن مخارق، فقد وثّقه الطبراني على ما نقله ابن حجر[703]، وقال فيه الدارقطني: «يضع الحديث»[704]. وقال ابن حبّان: «لا تجوز الرواية عنه ولا الاحتجاج به، إلا على سبيل الاعتبار»[705].
وداوُد بن أبي هند، من رجال البخاري في التعليقات، ومسلم، والأربعة، وثّقه عدّة من أئمّة هذا الشأن[706].
ومحمد بن سيرين، ثقة معروف من الأجلّاء، من رجال الستّة[707].
لا يمكن الحكم بصحّة هذا الخبر عن ابن سيرين؛ لوجود حصين بن مخارق الذي رماه الدارقطني بالوضع، لكن وثّقه الطبراني، فالخبر حينئذٍ يبقى قرينة ينُتفع فيها في المقام.
6 ـ خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين علي×
أخرجه أبو نعيم، قال: «حدّثنا محمد بن عمر بنِ سلمٍ، ثنا علي بن العباسِ، ثنا جعفر بن محمد بنِ حسين، ثنا حسين العربِي، عنِ ابنِ سلامٍ، عن سعد بنِ طرِيف، عن أصبغ بنِ نباتة، عن علي (رضي الله عنه)، قال: أتينا معه موضع قبر الحسين (رضي الله عنه)، فقال: ها هنا مناخ ركابِهِم، وموضع رحالِهم، وها هنا مُهراق دمائهم، فتية من آل محمد (صلّى الله عليه وسلّم) يُقتلون بهذه العرصة، تبكي عليهم السماء والأرض»[708].
وأورده عنه السيوطي في خصائصه[709].
وأورده الطبري في ذخائره، وابن حجر في صواعقه عن الملا في سيرته[710].
1 ـ محمد بن عمر بنِ سلمٍ، وهو الجعابي، الحافظ المشهور الذي تقدّم أهل زمانه في الحفظ، لكنّه كان شيعيّاً؛ لذلك حاولوا تضعيفه رغم شدّة حفظه، ومعرفته التامة بعلوم الحديث والرجال.
وقد جاء في ترجمته أقوال كثيرة تُفصح عن دقّة الرجل في حفظ الحديث ومعرفة علومه، فقد قال أبو علي النيسابوري: «ما رأيتُ في أصحابنا أحفظ من أبي بكر ابن الجعابي، حيّرني حفظه»[711].
وقال محمد بن الحسين بن الفضل القطان، أنّه سمع الجعابي قال لغلامه بعد أنْ أخبره بضياع كتبه: «يا بُنيّ لا تغتم، فإنّ فيها مائتي ألف حديث، لا يشكل عليّ منها حديث لا إسناداً ولا متناً»[712].
وقال أبو على التنوخي: «ما شاهدنا أحداً أحفظ من أبى بكر ابن الجعابي، وسمعت مَن يقول: إنّه يحفظ مائتي ألف حديث، ويجيب في مثلها، كان يفضل الحفّاظ بأنّه كان يسوق المتون بألفاظها، وأكثر الحفّاظ يتسمحون في ذلك، وكان إماماً في معرفة العلل وثقات الرجال وتواريخهم، وما يطعن على الواحد منهم، لم يبقَ في زمانه مَن يتقدّمه»[713].
وقد تُكلّم فيه بسبب المذهب، وبعضهم يرى أنّه خلط، فقد «ذكر أبو عبد الرحمن السلمي، أنّه سأل أبا الحسن الدارقطني عن ابن الجعابي: هل تكلم فيه إلا بسبب المذهب؟ فقال: خلط»[714].
غير أنّ الخطيب البغدادي، قال: «سألت أبا بكر البرقاني عن ابن الجعابي فقال: حدّثنا عنه الدارقطني، وكان صاحب غرائب، ومذهبه معروف في التشيع. قلت: قد طعن عليه في حديثه وسماعه؟ فقال: ما سمعت فيه إلّا خيراً»[715].
فالظاهر أنّه يمكن الاعتماد على حديث الرجل، ولا أقلّ أنّه يُعدّ من الأحاديث الحسان.
وأمّا علي بن العباس، فهو ابن الوليد المقانعي البجلي، فقد قال فيه الدارقطني: «ثقة صدوق»[716].
وجعفر بن محمد بن الحسين، المشهور بالترك، من الثقات الأثبات[717].
والحسين العربي، لعلّه الحسن بن الحسين العرني، والعرني هذا، صحّح له الحاكم في المستدرك[718]. وأخرج له البيهقي في السنن وسكت عنه[719]، والبيهقي صرّح بأنّه إذا أورد إسناداً فيه ضعف أشار إليه[720]، ولم نرَ منه إشارة إلى تضعيف الحسن هذا، فهو مقبول الحديث عنده.
وقال أبو حاتم: «لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة»[721].
وذكر ابن حبّان أنّه: «شيخ من أهل الكوفة، يروي عن جرير بن عبد الحميد والكوفيين المقلوبات»[722].
قلت: أبو حاتم، وابن حبّان كلاهما متشدّد في الجرح، وابن حبّان يقصب الراوي بالغلطة والغلطتين، وجرح أبي حاتم غير مفسّر، والحسن هذا من رؤساء الشيعة، فكان طبيعيّاً أنْ يُضعّف.
وابن سلام، الظاهر هو مصعب بن سلام التميمي؛ لأنّ من شيوخه سعد بن طريف، ومصعب هذا فيه خلاف، وقال فيه ابن معين: «لا بأس به»[723]. ووثّقه العجلي[724]. وقال أبو حاتم: «شيخ محلّه الصدق»[725]. وانتهى فيه ابن حجر إلى أنّه صدوق له أوهام[726]. وقال فيه الذهبي: «ومصعب، فصالح لا بأس به»[727]. ممّا يعني أنّ حديث من الحسان.
وأمّا سعد بن طريف، فالرجل معروف بالتشيّع والرفض، فكان طبيعيّاً أنْ يُضعّف ويُطعن به، فكثرت الكلمات في ذمّه، فقالوا ضعيف، وضعيف جدّا، ومتروك، وغير ذلك، بل اتّهموه بالوضع[728]، ومن الواضح أنّ ذلك كلّه بسبب عقيدته.
إلّا أنّ البخاري خفّف وطأة كلماتهم، فقال فيه: «ليس بالقوي عندهم»[729]. مما يعني أنّ حديثه وسط وهو الحسن.
والأصبغ بن نباتة، كذلك شيعي معروف، وكان من خاصّة أمير المؤمنين؛ لذا أخذ نصيبه من الذمّ والتضعيف في كلمات القوم، إلّا أنّ العجلي قال فيه: «كوفي تابعي ثقة»[730]. وسكت عنه البخاري في الكبير[731]. وقد تقدّم أنّ سكوت البخاري يُعدّ توثيقاً عند طائفة.
ومن الواضح أنّ المضعّفين لا دليل لهم على ضعفه سوى روايته لفضائل أمير المؤمنين ممّا لا يرتضيها القوم، وهذا ما يصرّح به ابن حبّان بكلّ وضوح، فقال: «وهو ممّن فُتن بحبّ على، أتى بالطامات في الروايات، فاستحق من أجلها الترك»[732].
ولذا فإنّ ابن عدي لا يرى بأساً في اعتماد روايته، فيقول: «وإذا حدّث عن الأصبغ ثقة، فهو عندي لا بأس بروايته، وإنّما أتى الإنكار من جهة مَن روى عنه؛ لأنّ الراوي عنه لعلّه يكون ضعيفاً»[733].
من خلال ما تقدّم لا يمكن الحكم بصحّة السند أعلاه، لكنّ هذا الخبر التاريخي يُعتبر قرينة تتقوّى بها سائر الأخبار الدالة على بكاء السماء والأرض على الحسين.
جاء في أمالي الشجري، قال: «أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن الحسين الجوزداني المقري، بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن شهدل المديني، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عقدة، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعيد أبو عبد الله، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا حصين، عن أبي حيّان التيمي، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي× احمرّت السماء، فقال الربيع بن خثيم: بكت السماء بواكيها، أَما إنّها ما بكت على أحد بعد يحيى بن زكريا÷ قبله×»[734].
هذا السند فيه عدّة مشاكل، فعبد الرحمن بن شهدل مجهول، وأحمد بن الحسن بن سعيد مجهول، روى عنه ابن عقدة وهو روى عن أبيه. وأبوه مجهول أيضاً، وحصين بن مخارق تقدّم الكلام فيه، وأنّه وثّقه الطبراني[735]. وقال فيه الدارقطني: «يضع الحديث» [736]. وقال ابن حبّان: «لا تجوز الرواية عنه ولا الاحتجاج به، إلا على سبيل الاعتبار»[737].أمّا الربيع بن خثيم فهو ثقة عابد مخضرم[738].
لكن من غير الواضح هل أنّ الربيع بن خثيم قد وقع في سند هذه الرواية وقد حدّث عنه أبو حيّان التيمي، أم أنّ الشجري أقحم قوله هنا بلا سند؟ هذا ما لم يتضح لي خصوصاً، ولم أجد هذا القول عند غير الشجري.
إنْ كان كلام الربيع قد نقله أبو حيّان، فالسند كما أوضحنا ضعيف، وإنْ كان لم يقع في السند المذكور، فهو مرسل من غير إسناد، فحكمه الضعف أيضاً.
ذكر المرعشي النجفي عن الديلمي في الفردوس: «عن عمّار بن ياسر، قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): السماء بكت لقتل يحيى بن زكريا، وأنّها لتبكي لقتل ابني هذا...»[739].
ولم نعثر على هذا الخبر في الفردوس المطبوع، وهو مرسل محكوم بالضعف؛ لعدم الوقوف على إسناده.
خلاصة الحكم على الأخبار المتقدّمة
اتضح من خلال ما تقدّم أنّ خبر بكاء السماء والأرض كما ورد صحيحاً معتبراً عند الشيعة الإمامية، فهو كذلك عند أهل السنّة، فقد عرفنا أنّ بعض الأسانيد جيدة لذاتها، وبعضها فيها نوع ضعف تصلح كمؤيد ومقوّي لبقيّة الأخبار.
إثبات أو نفي بكاء السماء والأرض
بعد أنْ استعرضنا الأخبار الدالة على البكاء من كتب الفريقين، وقمنا بدراستها وتقييمها سندياً، سنتعرض الآن لمسألة ثبوت هذه الظاهرة من عدمه، ومن خلال القرائن التي سنبرزها سيتضح أنّه لا إشكال في ثبوت هذه الظاهرة:
1 ـ كثرة الطرق، فقد عرفنا أنّ الخبر رُوي عن (24) راوٍ في كُتب الشيعة، وعن (6) رواة في كُتب السنّة، وهذا العدد من الرواة يكشف عن ثبوت الحادثة بلا شك.
2 ـ إنْ قلنا: إنّ ثبوت القضايا التاريخية يحتاج إلى طرق معتبرة، فقد عرفنا أنّ هناك طرقاً معتبرة في كُتب الفريقين أثبتت تلك الحادثة، ولا نرى مبرراً لنعود ونذكر الطرق المعتبرة التي تقدّمت دراستها.
3 ـ وكما ذكرنا في الفصلين الأوّل والثاني، فإنّ نفس ذكر الحادثة في كتب الفريقين واتفاقهم على نقلها، يُعدّ قرينة قوية على حصول الحادثة، ببيان ذكرناه هناك فلا نعيد. المبحث الرابع
تأمّلات مختصرة في دلالة الأخبار
أوّلا: بيان الأقوال في تفسير آية: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ...)[740].
رأينا من المناسب قبل أنْ ندخل في بيان دلالة الأخبار ومعطياتها أنْ نبيّن:
هل أنّ السماء والأرض من الممكن أنْ تبكي على الميّت أم لا؟ خصوصاً أنّ القرآن الكريم ذكر هذا الموضوع، فقال (عزّ من قائل): (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ).
فكان من الضرورة أنْ نتعرّض لآراء المفسرين في هذه الآية الشريفة، لمِا لها من دخالة في معرفة معنى البكاء على الحسين× في الروايات الآنفة الذكر.
وحيث إنّ الآراء والأقوال في تفسير هذه الآية عديدة؛ لذا سنعرض لها بإيجاز:
1 ـ إنّ المراد: أهل السماء والأرض، فحذفت كلمة (أهل) كما حذف في قوله تعالى: (وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)[741]، وفي قوله: (حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)[742]. أراد أهل القرية، وأصحاب الحرب[743].
2 ـ إنّه أراد تعالى المبالغة في وصف القوم بصغر القدر وسقوط المنزلة؛ لأنّ العرب إذا أخبرت عن عظم المصاب بالهالك، قالت: كسفت الشمس لفقده، وأظلم القمر، وبكاه الليل والنهار، والسماء والأرض، يريدون بذلك المبالغة في عِظم الأمر وشمول ضرره، وليس ذلك بكذب منهم؛ لأنّهم جميعاً متواطئون عليه، والسامع له يعرف مذهب القائل فيه، ونيتهم في قولهم: أظلمت الشمس، كادت تظلم، وكسف القمر: كاد يكسف، ومعنى (كاد): همّ أنْ يفعل ولم يفعل.
قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز:
|
الشمس طالعة ليست
بكاسفة |
|
تـبكي عليك نجوم الليل
والقمر |
أراد: الشمس طالعة تبكي عليه، وليست مع طلوعها كاسفة النجوم والقمر؛ لأنّها مظلمة، وإنّما تكسف بضوئها، فنجوم الليل بادية بالنهار، فيكون معنى الكلام: إنّ الله لمّا أهلك قوم فرعون لم يبكِ عليهم باكٍ، ولم يجزع جازع، ولم يوجد لهم فاقد.
وقال يزيد بن مفرغ الحميري:
|
الــريـح تـبـكي
شـجـوها |
|
والبرق يلمع في
الغمامة |
وهذا صنيعهم في وصف كلّ امرئ جلّ خطبه وعظم موقعه، فيصفون النهار بالظلام، وأنّ الكواكب طلعت نهاراً لفقد نور الشمس وضوئها...[744].
3 ـ أنْ يكون معنى الآية الإخبار عن أنّه لا أحد أخذ بثأرهم ولا انتصر لهم؛ لأنّ العرب كانت لا تبكي على قتيل إلّا بعد الأخذ بثاره، وقتل مَن كان بواء به من عشيرة القاتل، فكنّي تعالى بهذا اللفظ عن فقد الانتصار، والأخذ بالثار على مذهب القوم الذين خوطبوا بالقرآن[745].
4 ـ أنْ يكون محمولاً على البكاء حقيقة، وتكون الآية كناية عن أنّه لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يُرفع منها إلى السماء[746]، ويدلّ عليه ما رُوي عن أنس بن مالك عن رسول الله’ أنّه قال: «ما من مسلم إلّا وله في السماء بابان، باب يصعد فيه عمله، وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكيا عليه. وتلا (صلّى الله عليه وسلّم) هذه الآية»[747]. وعن عليّ׫إنّ المؤمن إذا مات بكى عليه مُصلّاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء، وإنّ آل فرعون لم يكن لهم في الأرض مُصلّى ولا في السماء مصعد عمل، فقال الله تعالى: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ) [748]. وإلى نحو هذا ذهب ابن عباس، والضحّاك، ومقاتل. «وقال مجاهد: ما مات مؤمن إلّا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً. فقيل له: أو تبكي؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود؟! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل؟!»[749].
وذكر السيد المرتضى أنّ معنى البكاء ههنا: «الإخبار عن الاختلال بعده كما يقال بكى منزل فلان بعده...» [750].
5 ـ ويمكن في الآية وجه خامس، وهو أنْ يكون البكاء فيها كناية عن المطر والسقيا؛ لأنّ العرب تُشبّه المطر بالبكاء، ويكون معنى الآية أنّ السماء لم تسقِ قبورهم، ولم تجد عليهم بالقطر على مذهب العرب المشهور في ذلك؛ لأنّهم كانوا يستسقون السحاب لقبور مَن فقدوه من أعزائهم، ويستنبتون لمواضع حفرهم الزهر والرياض..، والفعل الذي أُضيف إلى السماء وإن كان لا يجوز إضافته إلى الأرض، فقد يصحّ عطف الأرض على السماء بأن يُقدّر لها فعل يصحّ نسبته إليها، والعرب تفعل مثل هذا، قال الشاعر:
|
يا ليت زوجك قد
غدا |
|
مـتقلّداً سـيفاً
ورمحاً |
فعطف الرمح على السيف وإنْ كان التقلّد لا يجوز فيه، لكنّه أراد حاملاً رمحاً. ومثل هذا يقدر في الآية، فيقال: إنّه تعالى أراد أنّ السماء لم تسقِ قبورهم، وأنّ الأرض لم تعشب عليها، وكلّ هذا كناية عن حرمانهم رحمة الله ورضوانه [751].
ثانياً: معنى وحقيقة البكاء في الآية
بعد أنْ أوضحنا الأقوال في الآية المباركة، وأنّ بعضاً يحملها على البكاء بلا تأويل، فلا بدّ أنْ نقف قليلاً في المعنى المراد من البكاء، فقد ذكروا فيه احتمالات عدّة:
1 ـ إنّه كالمعروف من بكاء الحيوان، ويساعد عليه الأخبار العديدة الدالة على أنّ السماء والأرض تبكي على المؤمن، وقد تقدّم بعضها في النقطة رقم (4) من الأقوال في معاني الآية، وقد ذكر الطبري وغيره من المفسّرين عدّة روايات في ذلك، منها: ما رواه عن سعيد بن جبير: «عن ابن عباس: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ)، قال: إنّه ليس أحد إلّا له باب في السماء ينزل فيه رزقه ويصعد فيه عمله، فإذا فُقد بكت عليه مواضعه التي كان يسجد عليها، وإنّ قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض عمل صالح يُقبل منهم، فيصعد إلى الله (عزّ وجلّ). فقال مجاهد: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً [752].
ومنها: ما رواه، عن شريح بن عبيد الحضرمي، قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): إنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، أَلا لا غربة على المؤمن، ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلّا بكت عليه السماء والأرض، ثمّ قرأ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ)، ثمّ قال: إنّهما لا يبكيان على الكافر»[753]. وعن الضحّاك أنّه كان يقول: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ)، يقول: لا تبكي السماء والأرض على الكافر، وتبكي على المؤمن الصالح، معالمه من الأرض، ومقرّ عمله من السماء»[754].
وعن قتادة، في قوله: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ) قال: بقاع المؤمن التي كان يُصلّي عليها من الأرض تبكي عليه إذا مات، وبقاعه من السماء التي كان يُرفع فيها عمله»[755].
وعن عطاء الخراساني أنّه قال: «ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلّا شهدت له يوم القيامة، وبكت عليه يوم يموت»، وغير ذلك من الروايات العديدة[756].
وكما وردت هذه الروايات في كتب أهل السنّة، فقد وردت نظيراتها عند الشيعة الإمامية أيضاً، فقد روى الكليني، عن علي بن رئاب، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل× يقول: «إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها، وأبواب السماء التي كان يُصعَدُ أعماله فيها»[757].
وروى الشيخ الصدوق، عن أبي محمد الوابشي، عن الإمام الصادق×، أنّه قال: «ما من مؤمن يموت في أرض غربة، تغيب عنه فيها بواكيه إلّا بكته بقاع الأرض التي كان يعبد الله (عزّ وجلّ) عليها، وبكته أثوابه وبكته أبواب السماء التي كان يُصعد فيها عمله، وبكاه الملكان الموكلان به»[758].
وغير ذلك من الروايات[759].
2 ـ بكاء السماء حمرة أطرافها، وبكاء الأرض غبرتها:
أمّا تفسير بكاء السماء بالحمرة، فقد وردت فيه جملة من الآثار، وقد ذكر الطبري أثرين في ذلك، أحدهما ما تقدّم عن السُّدي، أنّه: «لمّا قُتل الحسين بن علي (رضوان الله عليهما) بكت السماء عليه، وبكاؤها حمرتها». والآخر عن عطاء في قوله: (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ) قال: بكاؤها حمرة أطرافها»[760].
ومن هذه الآثار أيضاً: ما تقدّم ذكره عن إبراهيم النخعي حين فسّر بكاء السماء بأنّها «تحمر وتصير وردة كالدهان، إنّ يحيى بن زكريا لّما قُتل احمرّت السماء وقطرت دماً، وإنّ حسين بن علي يوم قُتل احمرّت السماء»[761].
وأخرج ابن أبي الدنيا، عن الحسن البصري، قال: «بكاء السماء حمرتها».
وأخرج أيضاً عن سفيان الثوري أنّه قال: «كان يقال هذه الحمرة التي تكون في السماء بكاء السماء على المؤمن»[762].
وقد تقدّمت عدّة أخبار من كتب الفريقين فسّرت بكاء السماء والأرض على الحسين× بالحمرة فلا نُعيد.
وأمّا بكاء الأرض، فقد قال محمد بن علي الترمذي: «البكاء إدرار الشيء، فإذا أدرّت العين بمائها، قيل: بكت، وإذا أدرّت السماء بحمرتها، قيل: بكت، وإذا أدرّت الأرض بغبرتها، قيل: بكت؛ لأنّ المؤمن نور ومعه نور الله، فالأرض مضيئة بنوره وإن غاب عن عينيك، فإن فقدت نور المؤمن اغبرّت فدرّت باغبرارها؛ لأنّها كانت غبراء بخطايا أهل الشرك، وإنّما صارت مضيئة بنور المؤمن، فإذا قُبض المؤمن منها درّت بغبرتها...»[763].
3 ـ إنّ معنى بكاء السماء والأرض، هو أمارة تظهر منها تدلّ على أسف وحزن، أي: تظهر علامات في السماء والأرض تكشف عن حزنهما وأسفهما على فقدان ذلك المؤمن.
وقد ذكر هذه الوجوه الثلاثة القرطبي في تفسيره، ثمّ اختار القول الأوّل.
وقال: «قلت: والقول الأوّل أظهر؛ إذ لا استحالة في ذلك، وإذا كانت السماوات والأرض تُسبّح وتسمع وتتكلّم ـ كما بينّاه في سبحان و(مريم، وحم فصّلت) ـ فكذلك تبكي، مع ما جاء من الخبر في ذلك»[764].
ثالثاً: التحقيق في معنى بكاء السماء والأرض على الحسين × حسب لسان الروايات
بعد أنْ أوردنا عدّة أقوال واحتمالات في معنى بكاء السموات والأرض، نعود لنرى ما معنى بكاء السماوات والأرض على الحسين×، وأيّ هذه المعاني يتسق ويتفق مع الروايات المذكورة في أوّل البحث، وتبرز لدينا ها هنا عدّة احتمالات:
1 ـ أنْ يكون المعنى أنّه بكى على الحسين× أهل السموات وأهل الأرض.
2 ـ أنْ يكون المعنى كناية عن شدّة الحزن والمأساة على الحسين×، فجرى مجرى العرب في المبالغة عند فقدهم لشخص ذي شأن كبير، فيقولون: اظلمت الدنيا عليه، وبكت لفقده السماوات والأرض.
3 ـ أنْ تكون الحوادث الكونية الحاصلة من احمرار السماء والأرض تمثّل حالة البكاء التي حصلت على الحسين×.
4 ـ أنْ تكون الحوادث الكونية الأُخرى كمطر السماء دماً، وظهوره تحت الأحجار، مضافاً لاحمرار الشمس والأرض وغيرها من الحوادث، كلّها تُمثّل البكاء على الحسين×.
5 ـ أنْ يكون المراد أنّه بكى عليه موضع مصلّاه وسجوده في الأرض، ومصعد عمله من السماء، وغير ذلك ممّا تقدّم ذكره في البكاء على المؤمن، فيكون حاله حال المؤمن الذي يموت.
6 ـ أنْ يكون هو البكاء على الحقيقة، كما استظهره القرطبي في البكاء على المؤمن.
أمّا الاحتمال الأوّل، فهو في نفسه ممكن، خصوصاً أنّ الروايات دلّت أيضاً على بكاء كلّ الكون على الحسين×، كما ستأتي الإشارة إليه، إلّا أنّه يصطدم مع تفسير بعض الروايات، بأنّ بكاءها حمرتها، فهذه القيود في بعض الروايات تقيّد تلك الروايات التي اطلقت بكاء السموات من دون تبيين حقيقة البكاء، ومع هذا التقييد لا يمكن حملها على إرادة أهل السموات والأرض، بل المراد هو السموات والأرض حقيقة وبدون تأويل.
وأمّا الاحتمال الثاني، فهو ممكن أيضاً في حدّ ذاته، وسيكون المعنى كناية عن أنّ الحسين× يتمتع بمكانة عظيمة ومنزلة سامية، فرحيله يمثّل حالة من الحزن الشديد، وكأنّما قد بكى وحزن لفقده كلّ شيء، حتى السماوات والأرض، لكن هذا قد لا يتماشى مع الروايات المبيّنة لمعنى البكاء، بل للروايات المطلقة أيضاً، والتي يُشمّ منها أنّ المراد هو بكاء السماوات حقيقة، بل ولا يتماشى مع كلّ الأحداث الكونية التي جرت عند مقتل الحسين×، فهي تُفيد أنّ الأمر غير متعلّق بشدّة حزن المجتمع وعدمه، بل توضح أنّ هناك أُموراً تكوينية حصلت أيضاً، قد تُمثّل شدّة الحزن والأسى الذي حصل للكون أجمع، فالمعنى حينئذٍ يكون أنّ السماوات والأرض أظهرت حزناً شديداً على الحسين× تَمثّل في بكائهما عليه، وقد ظهرت الحمرة ونزل المطر وغير ذلك ممّا حصل كعلامة لذلك البكاء.
وأمّا الاحتمال الثالث، فهو منسجم مع لسان بعض الروايات ولا يتنافى مع مطلقاتها، وهو تفسير صريح لمعنى بكاء السموات والأرض، فتكون الحمرة التي ظهرت عبارة عن البكاء، لكن بالجمع مع بقيّة الآثار الكونية الحاصلة قد نستنتج أنّ الحمرة تمثّل أحد مصاديق البكاء لا غير.
وأمّا الاحتمال الرابع، فهو قريب أيضاً، فإنّ حمرة السماء والأرض لا تتنافى مع سقوط المطر ولا مع ظهور الدم، فكلّها علامات أصبغت الأرض والسماء بلون الدم حزناً وبكاءً على الحسين×، فتكون كلّ هذه الحالات تُمثّل بكاء للسماء والأرض.
وأمّا الاحتمال الخامس، فلا يمكن المصير إليه؛ إذ لا معنى حينئذٍ لتأكيد الروايات على بكاء السماء والأرض على الحسين×، مضافاً لتنافيه مع ما دلّ على أنّ السماء والأرض لم تبكِ إلّا على الحسين وزكريا÷، وسيأتي الكلام في خصوص هذا الأمر بعد قليل.
وأمّا الاحتمال السادس، فهو أيضاً احتمال وارد، وهو متناسب مع الروايات المطلقة في البكاء على الحسين×، ولا يتنافى مع روايات الحمرة إذا ما حسبناها مصداقاً من مصاديق البكاء.
والخلاصة التي يمكن الخروج بها من البحث هي: إنّه لا يوجد ما يمنع من كون البكاء الحاصل هو بكاء حقيقي، وهذا البكاء هو نتاج الحزن والأسى الشديدين، اللذين طالا كلّ مخلوقات الكون، فتفجّع العالم بأسره لتلك المأساة، والجريمة التي اُرتكبت بحق أبناء بيت رسول الله’، والتي أُريد من خلالها إخماد صوت الحق، وقتلٌ للعدالة، بل وللإنسانية أجمع، وكان ذلك بصورة بشعة، فظهرت علامات عديدة لهذا الحزن والأسى، فاحمرّت السماء ومطرت دماً، وأغبرت الأرض وظهر منها الدم، وغير ذلك ممّا حدث وجرى في ذلك اليوم المهول، والعلم عند الله أوّلاً وآخراً.
رابعاً: هل بكت السماء على غير الحسين×
لو لاحظنا الروايات التي أوردناها فيما سبق، لرأينا أنّ بعضها تتحدّث عن أنّ السماء والأرض بكت على الحسين× من دون أنْ تنفي بكائهما على غيره، لكن بعضها أوضحت أنّ السماء والأرض لم تبكِ على غير الحسين ويحيى بن زكريا÷، وحينئذٍ سوف يقع التعارض بينها وبين مجموعة من الروايات الدالة على أنّ السماء والأرض تبكي على المؤمن، وقد تقدّم قسم منها، وعرفنا أنّها وردت في كُتب الفريقين، وهي كثيرة لا نرى ضرورة لسردها، فما قدّمناه من نماذج ـ فيما تقدّم ـ يكفي في وضوح صورة التعارض بينها وبين ما دلّ على اختصاص البكاء بالحسين ويحيى بن زكريا÷.
من الواضح أنّ ـ كما عرفنا ـ الروايات وردت في كتب الفريقين، ولها طرق عدّة، وحينئذٍ فالنقاش السندي لا معنى له، بل بعد المراجعة تبيّن أنّ بعض طرق هذه الروايات عند الشيعة صحيحة السند، وبعضها عند السنّة صحيحة السند، فيبقى الأمر محصور في الجمع الدلالي.
وبنظرة تأملية في لسان الروايات يمكن القول بأنّ هذه الروايات ناظرة إلى بكاء موضع معيّن من السماء والأرض، وهو موضع مصلّاه، وعمود عمله وهكذا، بينما الروايات الواردة في بكاء السموات والأرض على الحسين× ناظرة لجميع السماء والأرض وغير مختصّة ببقعة معيّنة منها، وحينئذٍ فإنّ السماء والأرض بأجمعها لم تبكِ إلّا على الحسين ويحيى بن زكريا÷، ولا تنافي حينئذٍ بين الروايات.
كان من المفترض أنْ يكون هذا المبحث خارجاً عن هذا الفصل، لكن تسلسل البحث اضطرنا أنْ ندرجه هنا، لمِا تقدّم في طيّاته من تصريح بعض الأخبار بأنّ بكاء السماء على الحسين× هو حمرتها، وأنّ أحد معاني البكاء في الآية الشريفة (فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ) هو احمرار السماء، وتقدّمت عدّة من الروايات في ذلك؛ لذا رأينا من المناسب أنْ ندرج هذا الحدث الكوني في هذا الفصل.
وحيث إنّ المعنى قد تقدّم، وإنّ المراد من هذه الحمرة هو البكاء، أو شدّة حزن وأسى الكون بأجمعه على الحسين×؛ لذا سنقتصر على ذكر الروايات الدالة على حصول هذه الظاهرة بعد مقتل الحسين×، مع بعض الإشارات عن معنى الحمرة التي صارت مثاراً للجدل والكلام.
المطلب الأوّل: تخريج ودراسة الروايات الواردة من طرق الشيعة
تقدّم فيما سبق بعض الروايات وهي تدل بالمطابقة أو الإلتزام على احمرار السماء عند مقتل الحسين×، من قَبيل الدالة على أنّ بكاء السماء هو حمرتها، فهي بالتالي تدلّ على ظهور الحمرة في السماء عند مقتل الحسين×، أو من قَبيل الدالة على احمرار الشمس، فهي تدلّ أيضاً على ظهور الحمرة في السماء، فضلاً عن المصرّحة باحمرار السماء، كما أنّ بعض الروايات لم يتقدّم ذكرها لتعلّق موضوعها بحمرة السماء فقط، فلم تندرج في سياق المواضيع المتقدّمة.
فمن الروايات الدالة على حمرة السماء، ما يلي:
وقد تقدّم سابقاً، وجاء فيه، أنّ الإمام الصادق×، قال: «إنّ الحسين× بكى لقتله السماء والأرض واحمرّتا، ولم تبكيا على أحد قطُّ إلّا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي÷»[765].
وعرفنا فيما مضى أنّ إسناده معتبر (موثّق).
2 ـ خبر عبد الخالق بن عبد ربّه
وقد تقدّم أيضاً، وهو كذلك عن الإمام الصادق×، وجاء فيه:«سمعت أبا عبد الله× يقول: لم يجعل له من قَبلُ سميّاً، الحسين بن علي، لم يكن له من قَبلُ سميّاً، ويحيى بن زكريا× لم يكن له من قَبلُ سميّاً، ولم تبكِ السماء إلّا عليهما أربعين صباحاً. قال: قلت: ما بكاؤها؟ قال: كانت تطلع حمراء وتغرب حمراء»[766].
وسند هذا الخبر معتبر (موثّق) رجاله كلّهم ثقات، على ما تقدّم، كما أنّه له طرقاً أُخرى تمّ التطرّق لها سابقاً فلا نُعيد.
وقد تقدّم أيضاً، عن أبي عبد الله الصادق×، قال: «احمرّت السماء حين قُتل الحسين× سنة، ويحيى بن زكريا، وحمرتها بكاؤها»[767].
وسند هذا الخبر صحيح، رجاله كلّهم إمامية ثقات، وللحديث وجه آخر تقدّم سابقاً.
تقدّم أيضاً، وجاء فيه: «سمعت أبا عبد الله×، يقول: إنّ السماء بكت على الحسين بن علي، ويحيى بن زكريا، ولم تبكِ على أحد غيرهما. قلت: وما بكاؤهما[768]؟ قال: مكثوا أربعين يوماً تطلع الشمس بحمرة وتغرب بحمرة. قلت: فذاك بكاؤهما. قال: نعم»[769].
وسند الحديث ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن هلال الراوي المباشر، وقد تقدّم الكلام عنه وعن احتمال اتحاده مع عبد الله بن هلال بن جابان الذي يروي عنه ابن محبوب فلا نُعيد.
تقدّم أيضاً، وجاء فيه: «عن أبي عبد الله×، قال: كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زنا، وقاتل الحسين× ولد زنا، ولم تبكِ السماء على أحد إلّا عليهما. قال: قلت: وكيف تبكي؟ قال: تطلع الشمس في حمرة وتغيب في حمرة»[770].
وسند الحديث ضعيف؛ لجهالة عامر بن معقل.
وهو خبر طويل تقدّم سابقاً، نقتصر فيه على ذكر موضع الحاجة، فقد جاء فيه أنّ ميثماً التمّار قال لجبلة: «... يا جبلة، إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنّها دم عبيط، فاعلمي أنّ سيّدك الحسين قد قُتل. قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت الشمس على الحيطان كأنّها الملاحف المعصفرة، فصحتُ حينئذٍ وبكيت، وقلت: قد والله قُتل سيّدنا الحسين بن علي×»[771].
وقد تقدّم أنّ سنده ضعيف؛ لجهالة جبلة المكّية، فلم نقف على ترجمتها.
أخرجه الشيخ الصدوق، قال: «حدّثني بذلك محمد بن علي ماجيلويه&، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن لوط بن يحيى، عن الحارث بن كعب، عن فاطمة بنت علي (صلوات الله عليهما): ثمّ إنّ يزيد (لعنه الله) أمر بنساء الحسين×، فحُبسن مع علي بن الحسين÷ في محبس لا يكنهم من حر ولا قر حتى تقشرت وجوههم، ولم يُرفع ببيت المقدس حجر عن وجه الأرض إلّا وجد تحته دم عبيط، وأبصر الناس الشمس على الحيطان حمراء كأنّها الملاحف المعصفرة، إلى أن خرج علي بن الحسين÷ بالنسوة، وردّ رأس الحسين× إلى كربلاء»[772].
وقد عرفنا سابقاً أنّ سند هذا الخبر ضعيف.
وهذا الخبر لم يمرّ بنا سابقاً، أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبي&، عن سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن أحمد، عن عمر بن سهل، عن علي بن مسهر القرشي، قال: حدّثتني جدّتي أنّها أدركت الحسين بن علي حين قُتل، قالت: فمكثنا سنة وتسعة أشهر والسماء مثل العلقة، مثل الدم، ما تُرى الشمس»[773].
وهذا الخبر ضعيف؛ ويكفي في ذلك أنّ علي بن مسهر لا توجد له ترجمة عند الشيعة، وكذلك جدّته، وستأتي هذه الرواية في كتب السنّة، وسنعرف أنّ علي بن مسهر من الثقات عندهم.
وهذا الخبر تقدّم سابقاً وقد أخرجه ابن قولويه، عن أبي نصر، عن رجل من أهل بيت المقدس أنّه قال: «... واحمرّت الحيطان كالعلق»[774].
وقد تقدّم سابقاً أنّ هذه الرواية ضعيفة؛ لجهالة عدّة من رواتها.
ثمّ إنّ هذه الرواية وإنْ لم تُصرّح بظهور الحمرة، إلّا أنّ الظاهر من مجموع الأخبار أنّ هذه آثار الحمرة قد انعكست على الحيطان، فقد تقدّم فيما سبق أنّ الناس رأوا الشمس على الحيطان كأنّها الملاحف المعصفرة.
أورده الشيخ المفيد، قال: «وروى سعد الإسكاف قال: قال أبو جعفر×: «كان قاتل يحيى بن زكريا ولد زنا ، وقاتل الحسين بن علي× ولد زنا ، ولم تحمر السماء إلا لهما»[775].
والخبر كما هو واضح مرسل، فهو محكوم بالضعف من الجهة السندية.
أورده القاضي النعمان عن محمد بن معين الاصباغي، عن أبي معمر، قال: «أخبرني من أدرك مقتل الحسين×: مكثت السماء بعد مقتله شهرا حمراء»[776].
وهذا الخبر مرسل لم نقف على سنده، فهو محكوم بالضعف، كما أنّ القاضي النعمان من الإسماعيليّة، وينقل في كتابه هذا من السنّة والشيعة، ولم يتّضح لنا من أين أخذ هذه الرواية.
أورده القاضي النعمان، عنها، أنّها قالت: «قيل له[أي زوجها كعب بن مالك]: قتل الحسين بن علي×؟ قال: لا والله ما قتل ولو قتل نهارا لما أمسيتم حتى تروا لذلك علامة، ولو قتل ليلا أصبحتم حتى تروا لذلك علامة. قالت: فلما أمسوا احمرّ أفق المساء. فقال: ألا إنّه قتل الحسين بن علي×، بكت السماء عليه كما بكت على يحيى بن زكريا»[777].
وحكم هذا الخبر كسابقه، فهو مرسل محكوم بالضعف، ولم يتّضح لنا من أين أخذ القاضي النعمان هذه الرواية.
خلاصة الحكم على أسانيد روايات حمرة السماء عند الشيعة
تبيّن من خلال ما سردناه من الأخبار أعلاه، أنّ عدد الروايات الدالة على حمرة السماء من طرق الشيعة هي اثنتا عشرة رواية، وهذا العدد لوحده يورث الوثوق بحصول هذه الحادثة، فضلاً عن وجود عدد من الأخبار الصحيحة والمعتبرة في المقام.
المطلب الثاني: تخريج ودراسة الروايات الواردة من طرق أهل السنّة
وقد عرفنا أنّ مجموعة من الأخبار المتقدّمة قد فسّرت البكاء بالحمرة، فهي تدلّ على الحمرة بالملازمة، كما وقفنا بعد التتبع على مجموعة من الأخبار نصّت على حصول الحمرة عند مقتل الحسين× من دون أنْ تتعرّض لمسألة البكاء؛ لذا سنتعرّض لذكر الأخبار على شكل طائفتين:
الأُولى: الأخبار التي لم نذكرها سابقاً، ونصّت على حمرة السماء.
والثانية: إشارة موجزة إلى الأخبار التي فسّرت البكاء بحمرة السماء
أوّلاً: الأخبار التي نصّت على حمرة السماء ولم تقرنها بالبكاء
وهذه الأخبار عديدة، منها:
ورد هذا الخبر عن ابن سيرين بطرق عديدة:
الطريق الأوّل: هشام بن حسّان عنه
أخرجه ابن سعد، قال: «حدّثنا عفّان بن مسلم، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: لم تُرَ هذه الحمرة في آفاق السماء حتّى قُتل الحسين بن علي (رحمه الله)»[778].
وأخرجه أبو نعيم، من طريق عفّان أيضاً[779].
وأخرجه البلاذري، عن عمر بن شبّه، عن عفّان أيضاً[780].
وأخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى الحمّاني، ثنا حمّاد بن زيد، عن هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، قال: لم يكن في السماء حمرة حتّى قُتل الحسين»[781].
وأخرجه أبو نعيم من طريق الحمّاني أيضاً[782].
وأخرجه ابن الجوزي من طريق ابن بطة، قال: «وبالإسناد، قال ابن بطة [يعني الذي تقدّم ذكره، وهو: أخبرنا علي بن عبيد الله، أخبرنا علي بن أحمد السري[783]، أنبأنا عبد الله بن بطة[784]]: وحدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدّثنا سليمان بن حرب، عن حمّاد بن زيد، عن هشام، عن محمد بن سيرين، قال: لم تُرَ هذه الحمرة في السماء حتى قُتل الحسين»[785].
وأخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة، نا أبو بكر أحمد بن علي (ح) وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا محمد بن هبة الله، قالا: أنا محمد بن الحسين، أنا عبد الله، نا يعقوب، نا سليمان بن حرب، نا حمّاد بن زيد، عن هشام، عن محمد، قال: تعلم هذه الحمرة في الأفق ممَّ هو؟ فقال: من يوم قُتل الحسين بن علي»[786].
وأخرجه ثانية بسنده إلى عفّان: «نا حمّاد بن زيد، نا هشام، عن محمد، قال: لم نَرَ هذه الحمرة التي في آفاق السماء حتى قُتل الحسين بن علي...»[787].
وأخرجه الخوارزمي، لكنّه ذكر في السند محلّ هشام: هشيم، عن ابن سيرين، قال قيل له: «أتعلم هذه الحمرة في الأفق ممّ هي؟ قال: عرفت، من يوم قُتل الحسين بن علي»[788].
ويبدو أنّ ذكره لهشيم كان تصحيفاً مع أنّ هشيم ثقة من الأثبات أيضاً.
ثمّ إنّ الخوارزمي قال بعد الخبر: «وروى هذا الحديث أبو عيسى الترمذي»[789].
وهذا الخبر صحيح، رجال إسناده ثقات، فالطرق إلى حمّاد بن زيد متعدّدة، وحمّاد، وهشام، ومحمد بن سيرين من الثقات الأثبات.
ونقتصر هنا على دراسة طريق ابن سعد، الذي أخرجه عن عفّان بن مسلم، عن حمّاد، فعفّان بن مسلم ثقة ثبت[790]، وحمّاد بن زيد ثقة ثبت فقيه[791]، وهشام بن حسّان ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين[792].
ومحمد بن سيرين ثقة ثبت عابد كبير القدر[793].
فتبيّن أنّ هذا الطريق في غاية الصحة، ورواته كلّهم من الثقات الأثبات.
قد نقل الحافظ الزرندي، عن ابن الجوزي في التبصرة، عن ابن سيرين، أنّه قال: «لمّا قُتل الحسين أظلمت الدنيا ثلاثة أيام، ثمّ ظهرت هذه الحمرة في السماء»[794].
وكذلك نقله ابن حجر الهيتمي[795]، ونقل أيضاً في بعض نُسخ تذكرة الخواص[796]. لكن الموجود في التبصرة هو ما ذكرناه أعلاه، وهو: «لم تُرَ هذه الحمرة في السماء حتى قُتل الحسين»[797]. ولم نجد فيه أنّ الدنيا أظلمت ثلاثة أيام.
الطريق الثاني: يوسف بن عبدة عنه
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا يوسف بن عبدة، قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: لم تكن تُرى هذه الحمرة في السماء عند طلوع الشمس وعند غروبها حتى قُتل الحسين (رضي الله عنه)»[798].
وأورده الشيخ المفيد، قال: «وروى يوسف بن عبدة، قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: لم تُرَ هذه الحمرة في السماء إلّا بعد قتل الحسين×»[799].
وهذا السند ـ سند ابن سعد ـ محلّ كلام من جهة يوسف بن عبدة، فوثّقه يحيى بن معين، وذكره ابن حبّان في الثقات، ومال غيرهم إلى تضعيفه، فـ «قال الأثرم: قلت لعبد الله يوسف بن عبدة أبو عبدة: كيف هو؟ قال: له أحاديث مناكير عن حميد وثابت، وكأنّه ضعّفه. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي ضعيف، وقال العقيلي: له مناكير، قال: وأنكر عليه حمّاد بن سلمة حديثه عن ثابت عن أنس...»[800].
ولذا اختلفت النتائج فيه فوثّقه الذهبي[801]، لكن ابن حجر قال فيه: «ليّن الحديث»[802].
أمّا موسى بن إسماعيل المنقري فـ«ثقة ثبت»[803].
وعليه فيكون هذا الطريق صحيح السند وفق بعض المباني، وفيه ضعف خفيف طبق مباني أُخرى.
الطريق الثالث: عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين
أخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور، وأبو إسحاق إبراهيم بن طاهر بن بركات، قالا: أنا أبو القاسم بن أبي العلاء، أنا أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الروزبهان، أنا أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس الستوري، نا محمد بن مقبل، نا يحيى بن السري، نا روح بن عبادة، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، قال: لم تكن ترى الحمرة في السماء حتّى قُتل الحسين بن علي»[804].
وأخرجه ابن العديم في بُغيته[805].
وهذا الطريق فيه ضعف من جهة محمد بن مقبل، فلم أقف له على ترجمة، وكذلك يحيى بن السري، فإنّه مجهول، لكن يحيى يمكن اعتماد روايته؛ وذلك بعد التتبع فقد وقفنا على رواية عدّة من الثقات عنه، وهذا كافٍ في اعتماد الرجل.
فتبقى علّة هذا الخبر هي جهالة ابن مقبل لا غير، نعم، على القول باعتبار رواية المجهول يكون هذا الطريق معتبراً أيضاً، فرجاله كلّهم ثقات غير ابن مقبل.
على أنّه ورد الخبر من طريق آخر، عن ابن عون، فقد أخرجه محمد بن سليمان الكوفي، قال:«[حدّثنا] أبو أحمد، قال: حدّثنا إبراهيم بن الحسين، قال: حدّثنا عمّار، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أبي عون، عن محمد بن سيرين، قال: ما ظهرت الحمرة في السماء إلّا حين قُتل الحسين بن علي»[806].
وقد أورده مرّةً أُخرى باختلاف في السند، فقال: «[ حدّثنا ] أبو أحمد، قال: حدّثنا إبراهيم بن الحسين، قال: حدّثنا عفّان بن مسلم، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن أبي عون، عن محمد بن سيرين، قال: ما ظهرت الحمرة في السماء إلّا حين قُتل الحسين بن علي×»[807].
والظاهر أنّ هناك تصحيفاً طال السند، فقد ورد في السند الأوّل أنّ الراوي عن حمّاد هو عمّار، وفي الثاني هو عفّان بن مسلم، ويبدو أنّهما طريق واحد وقد تكرر سهواً، وأنّ الراوي عن حمّاد هو عفّان وليس عمّاراً، إذ لم نجد في تلاميذ حمّاد ولا شيوخ إبراهيم مَن اسمه عمّاراً، بينما وجدنا عفّاناً في كليهما.
ثمّ بعد ذلك عثرنا على الطبعة الثانية للكتاب، ووجدنا أنّ مَن قام بتحقيق الكتاب قد أثبت في المتن عثماناً وليس عمّاراً كما أوضحنا، وذكر في الهامش أنّه كان في النُّسختين اللتين تمّ الاعتماد عليهما (عمّار) بدل (عثمان)[808]، لكنّ تغيير متن الكتاب عن نسخته الخطية فيه مخالفة للتحقيق العلمي، فكان اللازم إثبات إسم (عمّار) كما هو والإشارة إلى أنّه (عفّان) في الهامش.
على أنّ إيراد المؤّلف للرواية بسندها ومتنها مع تغيير في هذا الراوي فقط، قد توحي أنّ المؤلف أيضاً وقف على السند تارةً بلفظ عمّار وأُخرى بلفظ عفّان، ويكون التحريف ليس في نسخته الخطية، بل فيما اعتمد عليه ونقل منه.
وكيفما كان، فالأمر يدور بين كون الراوي هو عفّان وهو الأقوى، أو أنّها نقلت تارةً عن عمّار، وأُخرى عن عفّان، وحيث إنّ عفّان ثقة ثبت فالأمر فيه سهل.
أمّا أبو عون، فهو نفسه ابن عون، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري[809]، فورود الرواية في المصادر الأُخرى عن ابن عون، وفي هذا الكتاب عن أبي عون ليس فيها تصحيفاً كما قد يُتوهم.
وكيف ما كان، فإنّ عفّان وحمّاد تقدّما، وكلاهما من الثقات الأثبات، وعبد الله بن عون ثقة ثبت أيضاً[810].
والراوي عن عفّان هو إبراهيم بن الحسين بن علي، وهو ابن ديزيل الهمذاني، الإمام الحافظ الثقة العابد[811].
فإنْ كان هناك كلام في السند فهو في شيخ المؤلّف أبي أحمد، وهو عبد الرحمن بن أحمد الهمداني؛ إذ لم أقف له على ترجمة، مع إكثار المؤلّف من النقل عنه، إذ نقل عنه (132) رواية، عن (58) شيخاً[812].
فتلخّص أنّ رجال هذا السند كلّهم من الثقات الأثبات باستثناء شيخ المؤلف؛ إذ لم أقف عليه، فهذا الطريق يصلح شاهداً قوياً يتقوّى به طريق ابن عساكر المتقدّم، ويكون المجموع حسناً لغيره.
خلاصة الحكم على خبر محمد بن سيرين
اتّضح أنّ لهذا الخبر عدّة طرق، الأوّل منها: صحيح بلا ريب ولا إشكال؛ فرواته كلّهم من الثقات الأجلّاء. وأمّا الطريق الثاني: فهو صحيح وفق مباني قوم، وفيه ضعف خفيف طبق مباني آخرين. وأمّا الثالث فضعيف؛ لجهالة أحد رواته، لكنّه منجبر بوروده من طريق آخر أيضاً.
والخلاصة: إنّ الخبر صحيح وثابت عن ابن سيرين؛ لوجود الطريق الصحيح، ولتعاضده مع الطريقين الآخرين.
أخرجه الحافظ المؤرخ أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم، قال: «وحدّثني بكر بن حمّاد، قال: حدّثني علي بن سليمان الهاشمي، قال: أبو العرب، وكان قدِم المغرب، وكان ثقة، عن حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّار، عن ابن عباس، قال: إنّما حدثت هذه الحمرة التي في السماء حين قُتل الحسين»[813].
بكر بن حمّاد، قال فيه ياقوت الحموي: «من حفّاظ الحديث وثقات المحدّثين المأمونين»[814]. وقال العجلي: «كان من أئمّة أصحاب الحديث»[815].
وعلي بن سليمان ثقة كما صرح أبو العرب في السند أعلاه.
حمّاد بن سلمة، ثقة، تقدّم سابقاً.
وعمّار بن أبي عمّار ثقة أيضاً تقدّمت الإشارة إليه.
تبيّن أنّ السند إلى ابن عبّاس صحيح.
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا علي بن محمد، عن علي بن مدرك، عن جدّه الأسود بن قيس، قال: احمرّت آفاق السماء بعد قَتل الحسين ستة أشهر، يُرى ذلك في آفاق السماء كأنّها الدم.
قال: [الظاهر أنّ القائل علي بن مدرك] فحدّثت بذلك شريكاً، فقال لي: ما أنت من الأسود؟ قلت: هو جدّي أبو أُمّي. قال: أَما والله، إن كان لصدوق الحديث، عظيم الأمانة، مُكرماً للضيف» [816].
وأخرجه من طريقه ابن عساكر[817].
وأورده المزي[818]، والذهبي[819].
أمّا علي بن محمد، فهو المدائني الأخباري المعروف، «قال [فيه] يحيى [بن معين]: «ثقة ثقة ثقة»[820].
وعلي بن مدرك، مجهول[821].
والأسود بن قيس، ثقة[822].
والخلاصة: إنّ هذا الخبر ضعيف؛ لجهالة علي بن مدرك.
هذا الخبر تقدّم سابقاً، أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدّثنا خلّاد ـ صاحب السمسم، وكان ينزل بني جحدر ـ قال: حدّثتني أُمّي، قالت: كنّا زماناً بعد مقتل الحسين وإنّ الشمس تطلع مُحمرّة على الحيطان والجدران بالغداة والعشي، قالت: وكانوا لا يرفعون حجراً إلّا وجدوا تحته دماً»[823].
وأخرجه ابن عساكر من طريق عمرو بن عاصم الكلبي، عن خلّاد، عن أُمّه، بلفظ يقرب من ذلك[824].
وسنده ضعيف؛ لجهالة خلّاد وأُمّه كما تقدّم.
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا منجاب بن الحارث، ثنا علي بن مسهر، حدّثتني جدّتي أُمّ حكيم، قالت: قُتل الحسين بن علي وأنا يومئذٍ جويرية، فمكثت السماء أياماً مثل العلقة»[825].
وأخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن سفيان: «... حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا إسماعيل بن الخليل، حدّثنا علي بن مسهر، قال: حدّثتني جدّتي، قالت: كنت أيام الحسين جارية شابة، فكانت السماء أياماً علقة»[826].
وأخرجه ابن عساكر من الطريق المذكور بنفس اللفظ[827].
وأخرجه من طريق آخر: «عن إسماعيل بن الخليل، عن علي بن مسهر، عن جدّته، قالت: لمّا قُتل الحسين كنت جارية شابة، فمكثت السماء سبعة أيام بلياليها كأنّها علقة»[828].
وأخرجه الخوارزمي من طريق يعقوب بن سفيان وأضاف في آخره: «بعد ما قُتل»[829].
وهذا الخبر ليس فيه ضعف إلّا من جهة أُمّ حكيم جدّة علي بن مسهر، فهي مجهولة، وأمّا السند إليها فصحيح بلا ريب، ونقتصر هنا على دراسة سند الطبراني، فرجاله كلّهم من الثقات، فالحضرمي من الحفّاظ الثقات المعروفين، وقد تقدّمت الإشارة إليه سابقاً.
ومنجاب بن الحارث، روى عنه مسلم، وأبو حاتم، وغيرهم، وذكره ابن حبّان في الثقات[830]. وقال بوثاقته الذهبي[831]، وابن حجر[832].
وعلي بن مسهر ثقة من رجال مسلم والبخاري والأربعة، ومن الحفّاظ الثقات[833].
لذا قال الهيثمي بعد نقله للخبر: «رواه الطبراني، ورجاله إلى أُمّ حكيم رجال الصحيح»[834].
نعم، يمكن التمسّك بصحة الخبر بناءً على إخراج البيهقي له وعدم قدحه فيه، فقد صرّح البيهقي بأنّه لا يخرج إلّا الصحيح، وإذا كان الحديث ضعيفاً أشار إليه، وقد أوضحنا ذلك سابقاً.
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد الكاهلي، حدّثنا منصور بن أبي نويرة، عن أبي بكر بن عياش، عن جميل بن زيد، قال: لمّا قُتل الحسين احمرّت السماء. قلت: أيّ شيء تقول؟ فقال: إنّ الكذّاب منافق، إنّ السماء احمرّت حين قُتل»[835].
الحضرمي، حافظ ثقة، وعبد الله بن يحيى، مجهول الحال لم أقف له على ترجمة، وقد روى عنه الحضرمي، وابن أبي شيبة في العرش.
ومنصور بن أبي نويرة، ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً[836]. وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «مستقيم الحديث»[837].
وأبو بكر بن عياش فيه كلام طويل يتعلّق بحفظه، والظاهر أنّه صدوق في أقلّ حالاته.
وجميل بن زيد هو الطائي، ضعيف[838].
تبيّن أنّ هذا السند ضعيف.
أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدّثني أبي، عن جدّي، عن عيسى بن الحارث الكندي، قال: لمّا قُتل الحسين (رضي الله عنه) مكثنا سبعة أيام، إذا صلينا العصر نظرنا إلى الشمس على أطراف الحيطان كأنّها الملاحف المعصفرة[839]، ونظرنا إلى الكواكب يضرب بعضها بعضاً»[840].
وأخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخه[841].
وأورده المزي في تهذيبه[842]، والذهبي في سيره[843].
الحضرمي حافظ ثقة أشرنا إليه سابقاً، وعثمان بن أبي شيبة العبسي، هو عثمان بن محمد بن إبراهيم من الحفّاظ الثقات المعروفين أيضاً [844].
وأبوه محمد بن إبراهيم ثقة أيضاً[845].
وأمّا جدّ عثمان (إبراهيم)، فقال البخاري: «سكتوا عنه»[846]. وقال ابن عدي: «له أحايث صالحة»[847]، لكن الكثير من أهل الفن صرّحوا بضعفه [848].
وعيسى بن الحارث، قال فيه أبو زرعة: «لا بأس به»[849].
اتّضح أنّ هذا الخبر ضعيف بعثمان وهو المسمّى بأبي شيبة، وقد قال فيه ابن عدي أنّ له أحاديث صالحة، فيكون الخبر قرينة قوية تتقوّى بها بقيّة الأخبار في المسألة محلّ البحث.
قال يحيى بن معين: «حدّثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، قال: قُتل الحسين بن علي ولي أربع عشرة سنة، وصار الورس الذي كان في عسكرهم رماداً، واحمرّت آفاق السماء، ونحروا ناقة في عسكرهم، فكانوا يرون في لحمها النيران»[850].
وأخرجه من طريقه ابن عساكر[851]، وأورده المزي في تهذيبه[852]، والذهبي في سيره[853].
وكذلك أخرجه الخوارزمي من طريق ابن معين أيضاً، لكن تصحّف عنده اسم الراوي المباشر إلى زيد بن أبي الزناد، كما اختلف متنه يسيراً، فبدل كلمة (النيران) وردت كلمة (المرار)[854].
وتقدّم أيضاً أنّ ابن أبي حاتم أخرجه من وجه آخر عن جرير، عن يزيد بن أبي زياد، أنّه قال: «لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما) احمرّت آفاق السماء أربعة أشهر، قال يزيد: واحمرارها بكاؤها»[855]. وسيأتي ذكره لاحقاً.
والسند جيد؛ فجرير بن عبد الحميد ثقة كما تقدّم، ويزيد أيضاً ثقة على كلام مرّ فيه مفصّلاً.
أخرجه الدولابي، قال: «أخبرني أبو عبد الله الحسين بن علي، قال: حدّثنا أبو محمد الحسن بن يحيى بن زيد بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، قال: حدّثنا حسن بن حسين الأنصاري، عن أبي القاسم مؤذن بني مازن، عن عبيد المكتب، عن إبراهيم النخعي، قال: لمّا قُتل الحسين احمرّت السماء من أقطارها، ثمّ لم تزل حتى تقطرّت فقطرت دماً»[856].
وأخرجه من طريقه ابن العديم في بُغيته[857].
وقد تقدّم هذا الخبر سابقاً في مطر السماء دماً، وعرفنا أنّه ضعيف؛ لجهالة اثنين من رواته.
أخرجه الشجري، قال: «أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن أحمد بن الحسين الجوزداني المقري، بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن شهدل المديني، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن عقدة، قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن سعيد أبو عبد الله، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا حصين، عن أبي حيّان التيمي، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي× احمرّت السماء...»[858].
وهذا السند ضعيف؛ ويكفي في ذلك أنّ عبد الرحمن بن شهدل مجهول، وأحمد بن الحسن بن سعيد مجهول، روى عنه ابن عقدة وهو روى عن أبيه، وأبوه مجهول أيضاً، وحصين بن مخارق تقدّم الكلام فيه، وأنّه وثقه الطبراني[859].وقال فيه الدارقطني: «يضع الحديث» [860]. وقال ابن حبّان: «لا تجوز الرواية عنه ولا الاحتجاج به، إلا على سبيل الاعتبار»[861].
11 ـ خبر الحسن بن الحسن بن علي
أخرجه الشجري معتمداً على السند السابق، قال: «حدّثنا حصين، عن مسكين السمان، عن محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه^، قال: لم تُر هذه الحمرة في السماء، حتى قُتل الحسين×»[862].
وقد عرفنا أنّ السند السابق فيه ثلاثة مجاهيل، على كلام في حصين بن مخارق، فيكون هذا السند ضعيف أيضاً، ولسنا بحاجة لتتبع بقيّة رجال إسناده، وإنْ كان محمد بن عبد الله (النفس الزكية)، وأبوه، وجدّه، كلّهم من الثقات.
وهذان الخبران سيأتي البحث عنهما ودراستهما في أوّل الفصل اللاحق؛ لأنّهما يتكلّمان عن رؤية الحيطان وكأنّها ملطّخة بالدم، ونحن نحتمل بقوة أنْ يكون انعكاس هذه الحمرة التي ظهرت في الكون قد تسببت في رؤية الحيطان بذلك الشكل؛ لذا فإنّهما من حيث المعنى قد يدخلان في هذه الحادثة، لكنّهما من حيث اللفظ مختلفان، لذلك أفردناهما ببحث مستقل تحت عنوان: (رؤية الحيطان وكأنّها ملطخة بالدم).
ثانياً: إشارة موجزة إلى الأخبار التي فسّرت البكاء بحمرة السماء
وهي مجموعة من الأخبار تقدّمت فيما سبق، منها:
قال ابن أبي حاتم: «حدّثنا علي بن الحسين، حدّثنا عبد السلام بن عاصم، حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا المستورد بن سابق، عن عبيد المكتب، عن إبراهيم (رضي الله عنه)، قال: ما بكت السماء منذُ كانت الدنيا إلّا على اثنين. قيل لعبيد: أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه وحيث يصعد عمله. قال: وتدري ما بكاء السماء؟ قال: لا. قال: تحمرّ وتصير وردة كالدهان، إنّ يحيى بن زكريا لمّا قُتل احمرّت السماء وقطرت دماً، وإنّ حسين بن علي يوم قُتل احمرّت السماء»[863].
وقد عرفنا أنّ هذا الخبر جيد الإسناد لا شائبة فيه.
أورده ابن كثير، قال: قال ابن أبي حاتم: «وحدّثنا علي بن الحسين، حدّثنا أبو غسان محمد بن عمرو زنيج، حدّثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما) احمرّت آفاق السماء أربعة أشهر، قال يزيد: واحمرارها بكاؤها»[864].
هذا الخبر يُمكن عدّه من الأخبار الجيّدة الحسنة في المقام كما تقدّم.
أخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو غالب بن البنّا، أنا محمد بن أحمد بن محمد بن حسنون، نا محمد بن إسماعيل بن العباس الوراق إملاءً، نا إسحاق بن محمد بن مروان، نا أبي، نا إسحاق بن يزيد، عن عبد الله بن مسلم، عن أبيه، عن قرّة، قال: ما بكت السماء على أحد إلّا على يحيى بن زكريا، والحسين بن علي وحمرتها بكاؤها»[865].
وقد عرفنا أنّ السند المذكور علّته الأساسية هو محمد بن مروان، وعرفنا أنّه مجهول الحال، وقد احتجّ بالمجهول جمع كبير من المحققين، مضافاً إلى أنّ الخبر يتعاضد مع بقيّة الأخبار الواردة في نفس الموضوع.
أخرجه الطبري، قال: «حدّثني محمد بن إسماعيل الأحمسي، قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي حمّاد، عن الحكم بن ظهير، عن السُّدّي، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضوان الله عليهما) بكت السماء عليه، وبكاؤها حمرتها»[866].
وقد تقدّم أنّه يمكن القول أنّ سند هذا الخبر جيّد، فالحكم بن ظهير علّته الأساس هي التشيّع، ومن أجلها تركوه ورموه بالضعف، فيمكن أنْ يعوّل على خبره هنا، خصوصاً عند ضمّه لغيره من بقيّة الأخبار.
خلاصة الحكم على أسانيد روايات حمرة السماء عند أهل السنّة
تبيّن من خلال ما سردناه من الأخبار أعلاه، أنّ عدد الروايات الدالة على حمرة السماء من طرق أهل السنّة هي خمس عشرة رواية، وهذا العدد لوحده يورث الوثوق بحصول هذه الحادثة، فضلاً عن وجود عدد من الأخبار الصحيحة في المقام: كخبر ابن سيرين، وخبر ابن عباس، وخبر إبراهيم النخعي، وخبر يزيد بن أبي زياد، وغيرها.
وفضلاً عن الخبرين الأخيرين في الطائفة الأُولى (خبر حصين، وخبر هلال)، فإنّهما على القول باتحاد الحادثة سيزيدانها قوّة، خصوصاً أنّ خبر حصين صحيح على ما سيأتي.
خلاصة الحكم على حادثة ظهور الحمرة في السماء
تبيّن من خلال ما قدّمناه أنّ هذه الحادثة روتها كتب الفريقين من السنّة والشيعة، وبطرق متعدّدة عند كلّ فريق، وكذلك فإنّ بعضها صحيح ومعتبر بحسب مباني كلّ فريق.
وهذه الأمور توجب الوثوق والاطمئنان بحصول هذه الحادثة وتحققها خارجاً.
أشكل بعض أهل السنّة بأنّ الحمرة إنّما هي مسألة تكوينية متعلّقة بغروب الشمس، فهي بمنزلة الشفق، ولا علاقة لها بمقتل الحسين×، وقال في ذلك ابن تيمية: «فإنّ هذا من الترهات، فما زالت هذه الحمرة تظهر ولها سبب طبيعي من جهة الشمس، فهي بمنزلة الشفق»[867].
لكنّ المتأمّل في روايات الحمرة يمكن أنْ يستنتج عدّة أُمور:
أوّلاً: إنّ الحمرة التكوينية الطبيعية إنّما تظهر في السماء عند غروب الشمس، ولا تظهر طوال اليوم أو أكثر أوقاته، ولا يوجد فيما بين أيدينا من الأخبار ما يدلّ على أنّ المراد هو الحمرة وقت الغروب حتى يقال بأنّ هذا أمر تكويني لا علاقة له بمقتل الحسين×.
ثانياً: الظاهر أنّ نقلة الحادثة كانوا يريدون حمرة معيّنة يُشار إليها في السماء؛ لأنّ حمرة الشفق لا تغيب عن ذهن ابن سيرين، وابن عباس، والنخعي، وغيرهم من الثقات الأجلّاء المعروفين الذين نقلوا الخبر، بل ولا تغيب عن غيرهم من الرواة، ولا ممّن سمعوه منهم ونقلوه إلى غيرهم بلا جدل ولا نقاش، وهذا يدلُّ على أنّ هناك حمرة ما في السماء كانت الناس تراها ولا تعرفها، فبيّن لهم ابن سيرين، وابن عباس، والنخعي، وغيرهم بأنّ هذه الحمرة حصلت حين مقتل الحسين×.
ثالثاً: إنّ بعض الأخبار قد حدّدت الحمرة المشار إليها بوقت معين كشهرين، أو ثلاثة، أو ستّة، وهذا يعني أنّهم لم يكونوا يقصدون حمرة الشفق؛ لأنّ حمرة الشفق غير مقيّدة بوقت معيّن.
رابعاًً: لو تنزلنا وقلنا: إنّ المراد بالحمرة هو الشفق في وقت المغرب فأيضاً سيكون المراد أنّ هذه الحمرة قد ازدادت وليست كسابقتها، فيكون إخبار ابن سيرين وغيره إنّما ناظر إلى هذه الحمرة الجديدة وهي المتسمة بالشدّة، فهذه الصورة الجديدة للحمرة لم تكن موجودة قبل مقتل الحسين×.
قال المجلسي: «يمكن أن يكون المراد كثرة الحمرة وزيادتها»[868].
وقال ابن الوزير: «فإن قيل: كيف يمكن صحّة هذا، وقد ثبت أنّ أوّل وقت العشاء زوال الشفق الأحمر عند أهل البيت، وأكثر الفقهاء؟ وذلك ثابتٌ منذ شُرِعَتِ الصلوات في وقت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ واتفق جمهور العلماء وأهل اللغة على أنّ الشفق هو الحمرة، حتى قال الزمخشري في (الكشَّاف): إنّ أبا حنيفة رجع إلى ذلك؛ لأنّه المخالف في ذلك.
قلت: يمكن أنّه كان شيئاً يسيراً، وأنّه كان في وقت قتل الحسين× حُمرةٌ عظيمةٌ متفاحشةٌ كما تقدّم ذلك عن أُمّ حكيم من رواية الطبراني بإسنادٍ رجاله ثقاتٌ، وأنّه بقيَ ذلك مدّة كثيرة إلى وقت كلام محمد بن سيرين المتكلّم بهذا، وهو من التابعين وعلمائهم وثقاتهم، ثمّ تناقص عن تلك الكثرة، كما تناقص الآيات المختصّة بمقتله×.
وقد اشتهرت قصة الحمرة بعد قتله (عليه أفضل السلام) حتَّى ذكرها المعرِّي في شعره على بُعده من الأفراد المشهورات من الشرائع، فقال:
|
وعلى الدَّهرِ مِنْ
دماء الشهيديـ |
|
ـنِ عــلــيٍّ
ونــجـلـه شــاهــدانِ |
|
فـهما فـي أواخـر
الـليلِ فـجرانِ |
|
وفــــي أُولــيـاتـهِ
شَـفَـقَـانِ»[869]. |
خامساً: فسّر بعض العلماء هذه الحمرة بنحو لا يمكن أنْ يكون المراد منها الحمرة المعتادة، وإنّما هي حمرة أخرى تعبّر عن عدم الرضا الإلهي، وغضبه سُبحانه وتعالى على هؤلاء القوم؛ لمِا ارتكبوه من جرم كبير لا يغتفر، وجناية عظيمة اهتز لها عرشه، وهي قتلهم الحسين×، وهو ما أشار إليه عبد الرحمن بن الجوزي، حين قال: «لمّا كان الغضبان يحمرّ وجهه فيتبيّن بالحمرة تأثير غضبه، والحقّ سُبحانه ليس بجسم، أظهر تأثير غضبه بحمرة الأفق حين قُتل الحسين»[870].
الفصل الرابع : في بيان حوادث كونية متفرّقة جرت بعد مقتل الحسين×
أوّلاً: رؤية الحيطان وكأنّها ملطخة بالدم
والخبر بهذا اللفظ لم نعثر عليه إلّا في كتب أهل السنّة، وقد رُوي عن اثنين، وهما: أبو الحصين، وهلال بن ذكوان.
أخرج البلاذري في أنسابه، قال: «حدّثنا سعيد بن سليمان، حدّثنا عبّاد بن العوّام، عن أبي حصين، قال: لمّا قُتل الحسين مكثوا شهرين أو ثلاثة، وكأنّما تلطّخ الحيطان بالدم، من حين صلاة الغداة إلى طلوع الشمس»[871].
وبنحوه أورده الطبري، وابن كثير، وابن العديم، وأرسلوه إرسال المسلّمات بلفظ: قال حصين، كما سيأتي[872].
سعيد بن سليمان الضبي الملقّب بسعدويه، ثقة حافظ[873].
وعبّاد بن العوّام، ثقة[874].
وأبو حصين، الظاهر أنّه حصين بن عبد الرحمن، وليس أبا حصين، وقد وقع تحريف في المتن؛ لأنّ عبّاد بن العوّام يروي عن حصين بن عبد الرحمن، ولا يروي عن أبي حصين، كما أنّ الطبري وكذلك ابن كثير نسبا القول لحصين على ما سيأتي.
مضافاً لذلك، فإنّه في نفس أنساب البلاذري، نجد أنّ هناك خبرين آخرين يروي فيهما عبّاد بن العوّام عن حصين وليس عن أبي حصين، وكلاهما بنفس السند: البلاذري، سعيد بن سلمان (سعدويه)، عبّاد بن العوّام، حصين[875].
وحصين هذا هو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي، حافظ ثقة حجّة[876].
وقد توفّيَ في سنة (136هـ) وعمره (93)سنة، ممّا يعني أنّ عمره في وقعة عاشوراء كان (18) سنة.
والخلاصة: إنّ هذا الخبر صحيح الإسناد، ولعلّه لوضوح صحة إسناده فقد أرسله الطبري، وكذا ابن كثير إرسال المسلّمات مع اختلاف يسير في اللفظ، فقالا: قال حصين: «فلمّا قُتل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثة، كأنّما تلطّخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع»[877].
أخرجه سبط ابن الجوزي، قال: «أخبرنا غير واحد، عن علي بن عبيد الله، أخبرنا علي بن أحمد بن البسري، أخبرنا أبو عبد الله بن بطه، أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي، حدّثنا هلال بن بشر، عن عبد المطلب بن موسى[878]، عن هلال بن ذكوان، قال: لمّا قُتل الحسين مكثنا شهرين أو ثلاثة، كأنّما لُطّخت الحيطان بالدم، من صلاة الفجر إلى غروب الشمس»[879].
رجال السند
الظاهر أنّ هذا السند لا شائبة فيه لولا جهالة الراوي المباشر هلال بن ذكوان، فلم نقف له على ترجمة، وأمّا بقيّة رجاله فبين ثقة وصدوق، وقد تقدّم الكلام في بعضهم، ولم يتبقَ غير علي بن عبيد الله (الزاغوني، ابن أبي السري)، وعلي بن أحمد بن البسري، وأبو عبد الله بن بطة (عبيد الله بن محمد العكبري)، وكلّهم ثقات لا نرى حاجة لتفصيل الكلام فيهم بعد معرفتنا بجهالة هلال بن ذكون.
والخلاصة: إنّ السند ضعيف بهلال بن ذكوان وهو صالح لأن يتقوّى ويتعاضد مع بقيّة الأخبار الدالة على حصول تلك الحادثة.
اتّضح أنّ هذه الحادثة وردت بسند صحيح عند البلاذري، وسند آخر فيه ضعف؛ بسبب جهالة الراوي هلال بن ذكوان، إلّا أنّه يصلح قرينة يتقوّى بها خبر البلاذري، وقد أرسل الطبري الخبر إرسال المسلّمات، فالظاهر أنّ الحادثة ثابتة، خصوصاً أنّ ابن الأثير الجزري أرسل الحادثة باختلاف يسير إرسال المسلمات، فقال: «ومكث الناس شهرين أو ثلاثة، كأنّما تلطّخ الحوائط بالدماء، ساعة تطلع الشمس حتّى ترتفع»[880].
الارتباط بين الحادثة وبين حمرة السماء
عرفنا فيما سبق أنّ حادثة احمرار السماء عند مقتل الحسين× ثابتة، قد وردت بأسانيد عديدة عن عدّة كثيرة من الرواة، وبعض طرقها صحيحة، ومن تلك الأخبار ما دلّ على انعكاس الحمرة على الحيطان حتى بدت وكأنّها الملاحف المعصفرة، من هنا يتوجه احتمال أنْ تكون هذه الحادثة هي انعكاس لحمرة السماء، فكانوا يرون الحيطان كأنّها ملطّخة بالدم من شدّة الحمرة؛ ولذا لم يقولوا في الخبر بأنّهم رأوا الدم على الحيطان، بل قالوا كأنّها ملطّخة بالدم، وهذا يقوّي احتمالية انعكاس تلك الحمرة على الحيطان، فتكون هذه الروايات مثبتة لحادثة الحمرة أيضاً، وتتعاضد مع سابقاتها وتعطي الحادثة وثوقاً أكثر.
ثانياً: انكسفت الشمس واظلمت السماء حتى بدت الكواكب
وهذا المعنى قد ورد عند السنّة والشيعة باختلاف في اللفظ:
أـ الروايات عند أهل السنّة
أمّا ما ورد عند أهل السّنة، فهو عدّة أخبار، وهي:
أخرجه البلاذري، قال: «حدّثنا عمرو، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل [قال]: إنّ السماء أظلمت يوم قُتل الحسين حتّى رأوا الكواكب»[881].
وأخرجه البيهقي في سننه، قال: «وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، حدّثني أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، أنبأ ابن لهيعة، عن أبي قبيل، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، كسفت الشمس كسفةً بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أنّها هي»[882].
ومن طريقه ابن عساكر[883]، والخوارزمي[884].
وأورده المزي في التهذيب، قال: «وقال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل: لمّا قُتل الحسين بن علي كسفت الشمس كسفةً، بدت الكواكب نصف النهار، حتى ظننا أنّها هي»[885].
وأخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا قيس بن أبي قيس البخاري، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي قبيل، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنه)، انكسفت الشمس كسفةً، حتّى بدت الكواكب نصف النهار، حتّى ظننا أنّها هي»[886].
ومن طريقه، أخرجه أبو نعيم[887]، والكنجي الشافعي[888].
من الواضح أنّ السند يدور على عبد الله بن لهيعة، وأبي قبيل، وقد رُويت عنهم بثلاث طرق، وهذه الطرق الثلاثة كلّها صحيحة، لا نرى ضرورة للخوض فيها، ونُشير لها مجملاً، ففي سند البلاذري، عمرو بن محمد الناقد، ثقة، وعبد الله بن وهب المصري، ثقة حافظ.
وفي سند البيهقي كلّهم ثقات معروفين، وعبد الجبار أبو الأسود، ثقة أيضاً.
وفي سند الطبراني قيس بن أبي قيس البخاري، ثقة، وقتيبة بن سعيد، ثقة ثبت.
فالسند إلى عبد الله بن لهيعة صحيح من غير ريب.
وأمّا عبد الله بن لهيعة، فقد اختلفت فيه الأقوال، وقد خلص أهل الفن إلى نتائج مختلفة أهمّها:
1 ـ أنّه ثقة صحيح الحديث، كما ذهب إليه العلّامة أحمد محمد شاكر، حيث قال في تحقيقه على سنن الترمذي: «وهو ثقة صحيح الحديث، وقد تكلّم فيه كثيرون بغير حجّة من جهة حفظه، وقد تتبعنا كثيراً من حديثه، وتفهمّنا كلام العلماء فيه، فترجّح لدينا أنّه صحيح الحديث، وأنّ ما قد يكون في الرواية من الضعف إنّما هو ممّن فوقه أو ممّن دونه، وقد يُخطئ هو كما يُخطئ كلّ عالم وكلّ راوٍ»[889].
وقيّد صحة رواياته في تحقيقه على المسند فيما إذا روى عنه ثقة حافظ معروف، فقال: «وهو ثقة، تكلّموا فيه من قِبل حفظه بعد احتراق كُتبه، ونحن نرى تصحيح حديثه إذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفين»[890].
2 ـ أنّه حسن الحديث، وهذا ما ذهب إليه الحافظ نور الدين الهيثمي، حيث حسّن له أحاديث عديدة في كتابه مجمع الزوائد بقوله: «وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن»، أو بقوله: «وهو حسن الحديث»[891]، أو غير ذلك[892]. وكذلك ذهب إليه السيوطي[893]، والفتني[894]، والمناوي[895]، والشوكاني[896].
وقد صرّح الألباني بهذه الحقيقة، وهي أنّ من العلماء مَن يُصحّح حديث ابن لهيعة، ومنهم مَن يُحسّن حديثه، فقال في كتابه جلباب المرأة المسلمة، عند كلامه عن حديث في سنده ابن لهيعة: «وعلّته ابن لهيعة... وهو ثقة فاضل، لكنّه كان يحدّث من كُتبه، فاحترقت، فحدّث من حفظه، فخلط، وبعض المتأخرين يحسّن حديثه وبعضهم يصحّحه»[897].
3 ـ أنّ حديثه معتبر ما قبل احتراق كُتبه، وضعيف ما بعد احتراقها، إلّا أنّه يصلح في المتابعات والشواهد، وممّن ذهب إلى هذا الرأي الحافظ ابن حجر العسقلاني، وكذا الشيخ الألباني، والشيخ الحويني الأثري، وغيرهم.
قال ابن حجر: «عبد الله بن لهيعة... صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كُتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون»[898].
أمّا الألباني فقد تقدّم قوله بأنّ ابن لهيعة خلط بعد احتراق كُتبه، وقال في الصحيحة: «ابن لهيعة فيه كلام لا يخفى، والأحاديث التي نوردها في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) من روايته أكثر من أن تُحصر، بيد أنّ هذا الكلام فيه ليس على إطلاقه، فإنّ رواية العبادلة الثلاثة عنه صحيحة، وهم: عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقريء، فإنّهم رووا عنه قبل احتراق كُتبه، كما هو مشروح في ترجمته من التهذيب»[899]. وحين سُئل عن رأيه حول مَن ينكر احتراق كُتبه وبالتالي اختلاطه بعدها، أجاب: «هذا غير صحيح، فابن لهيعة قد اختلط بعد احتراق كُتبه، ومَن روى عنه قبل اختلاط كُتبه، فحديثه صحيح»[900]، وذكر بعد ذلك أنّه وقف حتّى ساعة السؤال على ثلاثة عشر راوياً رووا عن ابن لهيعة قبل احتراق كُتبه، وعدّ منهم عبد الله بن وهب، وقتيبة بن سعيد[901].
وقال الحويني: «والحق أنّ حديث ابن لهيعة من رواية القدماء عنه قويٌ مقبول، ولم يكن دلّس فيه، أمّا بعد احتراق كُتبه، فقد وقعت منه مناكير كثيرة في حديثه...». ثمّ ذكر جملة ممّن وقف عليهم أنّهم رووا قبل الاحتراق، وعدّ منهم ابن وهب[902].
ومن خلال ذلك يتّضح أنّ حديث ابن لهيعة في الخبر أعلاه يكون مقبولاً على كلّ الأقوال الثلاثة المتقدّمة؛ لأنّه إمّا صحيح الحديث مطلقاً، أو حسن الحديث مطلقاً، أو صحيح برواية القدماء عنه، وقد روى عنه في الخبر أعلاه عبد الله بن وهب كما في سند البلاذري، وقتيبة بن سعيد كما في سند الطبراني.
وأمّا أبو قبيل فهو حيي بن هانئ، وثّقه عدّة من أئمّة الشأن، منهم أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، والدارقطني، والعجلي، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وابن معين، وأحمد بن صالح المصري[903].
نعم، قال فيه أبو حاتم: «صالح الحديث»[904]. وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «وكان يخطئ»[905]. ومع ملاحظة تشدّدد أبي حاتم، وكذا ابن حبّان، وأيضاً ملاحظة أنّ الخطأ لا يسلم منه راوٍ ما، سيتضّح أنّ الرجل ثقة، وإذا تنزلنا عن ذلك، فحينئذٍ يدور الأمر فيه بين كونه صدوقاً أو ثقة، وقد انتهى الأرنؤوط وبشّار عوّاد إلى أنّه ثقة[906].
والخلاصة: إنّه بناءً على وثاقة ابن لهيعة، ووثاقة أبي قبيل، فإنّ الخبر صحيح الإسناد، وأمّا بناءً كون أحدهما صدوقاً فالسند حسن، وهو ما ذهب إليه الهيثمي، حيث قال: «رواه الطبراني وإسناده حسن»[907].
عرفنا أنّ لفظ الحديث عند البلاذري هو أنّ السماء أظلمت، بينما في الطريقين الآخرين عند البيهقي والطبراني، أنّ الشمس انكسفت، والظاهر أنّه لا يوجد خبران لأبي قبيل في الموضوع، بل هو خبر واحد بقرينة أنّ كلّ الطرق هي عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، فالظاهر أنّ هناك نقلاً بالمعنى لاستلزام الكسوف للظلام كما هو واضح، فالراوي حين رأى الظلام ظنّ أنّ الشمس انكسفت؛ لذا اختلف الرواة في النقل فبعضهم نقل انكساف الشمس، وبعضهم نقل حصول الظلام، والله أعلم.
وما يؤيد ذلك أنّ بقيّة الرواة غير أبي قبيل أيضاً اختلفوا فبعضهم نقل الكسوف، وبعضهم نقل الظلام، وسيأتي مزيداً من الكلام عن ذلك فيما يأتي.
تقدم أنّ هذا
الخبر أخرجه ابن عساكر، عن خلف بن خليفة، عن أبيه، قال:
«لمّا قُتل الحسين اسودّت السماء وظهرت الكواكب نهاراً، حتّى رأيت الجوزاء عند
العصر، وسقط التراب الأحمر»[908].
وأورده المزي في تهذيبه[909].
وقد تبيّن من خلال دراسة الرجال أنّ سند هذا الخبر حسن لذاته.
وقد تقدّم سابقاً أنّ هذا الخبر أخرجه ابن عساكر من طريق البيهقي، والخطيب، وابن هبة الله، بسندهم إلى أُمّ حيّان، قالت: «يوم قُتل الحسين أظلمت علينا ثلاثاً...»[910].
وقد تقدّم ما يتعلّق بتخريج الخبر.
وأمّا من حيث السند فقد تقدّم فيه الكلام مفصّلاً وتبيّن أنّ الخبر ضعيف، لكن الضعف ليس شديداً؛ لأنّه يتعلّق بالجهالة، فيكون صالحاً لأنْ يتقوّى مع غيره.
هذا، وقد أشرنا سابقاً أنّ ابن عساكر والسيوطي نسبوا تخريج الرواية إلى البيهقي، وعرفنا فيما تقدّم أنّ البيهقي إذا خرّج حديثاً وسكت عنه، فهو صحيح معتبر عنده، وهذا ما يقوّي صحة الطريق أعلاه، وصحة أصل الخبر.
وهذا الخبر روته المصادر الشيعية، نقلاً عن المصادر السنيّة، فقد رواه الشيخ الصدوق في الأمالي والإكمال، والراوندي في الخرائج، وعنهم أخذه الكثير كالبحار وغيره.
أمّا رواية الشيخ الصدوق، فهي عن محمد بن أحمد السناني (رضي الله عنه) كما في الأمالي[911]، وأحمد بن الحسن بن القطان «وكان شيخاً لأصحاب الحديث ببلد الري، يعرف بأبي علي بن عبد ربّه» كما في الإكمال[912]، كلاهما قالا: حدّثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، قال: حدّثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، قال: حدّثنا تميم بن بهلول، قال: حدّثنا علي بن عاصم، عن الحصين بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عباس.
وقال الراوندي في الخرائج: بأنّ هذا الخبر«يُروى عن مشيخة المخالفين، عن شيخ لأصحاب الحديث بالري يعرف بأبي علي بن عبد ربّه، قال: ثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، ثنا بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن علي بن عاصم، عن الحصين بن عبد الرحمان، عن مجاهد، عن ابن عباس».
قال: «وتُروى عن شيخ لهم بأصفهان يعرف بأبي بكر بن مردويه بإسناده عن ابن عباس»[913].
وأصل الخبر مع عدم ذكر بعض التفاصيل، وعدم التعرّض لمسألة الكسوف أيضاً، رواه ابن الأعثم في الفتوح[914].
والخبر طويل وخلاصة موضع الشاهد منه كما رواه في الخرائج عن ابن مردويه، أنّ الإمام علي× حين مرّ بكربلاء بكى بكاءً طويلاً، وبيّن لابن عباس أنّ الإمام الحسين× سيُقتل هنا، وأنّ في هذا المكان بعر الظباء، وهي مصفرة لونها لون الزعفران، فأمر ابن عباس أنْ يطلبها، فوجدها ابن عباس كما وصفها الإمام، فأخذها الإمام وشمّها، وهو يقول: هي هي بعينها، أتعلم يا بن عباس، ما هذه الأباعر؟ هذه قد شمّها عيسى من مريم، وقال: هذا الطيب لمكان حشيشها، ثمّ إنّ الإمام أخذ من البعر وصرّه في ردائه، وأمر ابن عباس كذلك، وقال له: «إذا رأيتها تنفجر دماً عبيطاً، فاعلم أنّ أبا عبد الله قد قُتل بها [ودفن]. قال ابن عباس: لقد كنت أحفظها، ولا أحلّها من طرف كمّي، فبينا أنا في البيت نائم وقد خلا عشر المحرّم إذ انتبهت، فإذا تسيل دماً، فجلست وأنا باكٍ، فقلت: قُتل الحسين، وذلك عند الفجر، فرأيت المدينة كأنّها ضباب، ثمّ طلعت الشمس وكأنّها منكسفة، وكأنّ على الجدران دماً، فسمعت صوتا يقول وأنا باكٍ:
|
اصـبـروا آل الـرسـول |
|
قُتل الفـرخ البجـول[915]. |
|
نـــزل الــروح
الأمـيـن |
|
بـــبــكــاء
وعـــويـــل |
ثمّ بكى وبكيت، ثمّ حدّثت الذين كانوا مع الحسين، فقالوا: لقد سمعنا ما سمعت ونحن في المعركة، فكنّا نرى أنّه الخضر×»[916].
خلاصة الحكم السندي في هذا الخبر
وهذا السند ضعيف على كلا المبنيين؛ ويكفي في ذلك جهالة وضعف بعض رجاله، فمثلاً: أحمد بن يحيى بن زكريا القطان، مجهول عند الشيعة، ولم أقف له على ذكر عند أهل السنّة، وتميم بن بهلول، مجهول عند الشيعة، وليس له ذكر عند أهل السنّة، وعلي بن عاصم، ضعيف عند أهل السنة، وليس له ذكر عند الشيعة، والمذكور عند الشيعة مختلف الطبقة عن ذاك كما أوضح السيّد الخوئي[917]. وهكذا بقيّة الرجال بين الجهالة والخلاف بين الفريقين، فلا يسلم السند على مبنى أيّ منهما، فالخبر بهذا السند ضعيف.
أضف إلى ذلك ففي الخبر ما يدلّ على ضعفه أيضاً، وهو أنّ ابن عباس كان أعمى، فكيف تمكّن من رؤية سيلان الدم وانكساف الشمس وما إلى ذلك من الأُمور المذكورة في الرواية؟!
مضافاً لمِا سيأتي في بعض الأخبار بأنّ أُمّ سلمة رأت تحوّل التربة دماً وصرخت، وجاءها الناس وكان ممّن جاء مستفسراً عن الوضع هو ابن عباس يقوده قائده، ممّا يدل على أنّ ابن عباس قد عرف الخبر من أُمّ سلمة!
روى أبو الشيخ في كتاب (السنّة) كما نقله الزرندي في نظم درر السمطين، بسنده إلى يزيد بن أبي زياد، قال: «شهدت مقتل الحسين وأنا ابن خمس عشرة سنة، فصار الورس في عسكرهم رماداً، واحمرّت السماء لقتله، وانكسفت الشمس لقتله، حتى بدت الكواكب نصف النهار، وظنّ الناس أنّ القيامة قد قامت، ولم يُرفع حجر في الشام إلّا رؤى تحته دم عبيط»[918].
لكن من المؤسف أنّ كتاب السنّة لأبي الشيخ لم يصل إلينا، فلم نقف على سنده، فيكون الخبر مرسلاً.
أورده سبط ابن الجوزي، قال: وقال الشعبي: «لمّا قُتل الحسين اسودّت الدنيا ثلاثة أيام، ورمت السماء رملاً أحمر»[919].
ومن الواضح أنّ الخبر المرسل محكوم بالضعف.
ب ـ الروايات الواردة عند الشيعة
أرسلها ابن شهر آشوب عن أبي مخنف في رواية: «... وانكسفت الشمس إلى ثلاثة أسبات»[920]، وعنه المجلسي[921]، والبحراني[922].
وهي مرسلة بلا سند محكومة بالضعف.
وقد فسّر المجلسي المقصود من ثلاثة أسبات، أي: ثلاثة أسابيع بدأت من السبت، قال: « قوله (إلى ثلاثة أسبات)، أي: أسابيع، وإنّما ذكر هكذا؛ لأنّهم ذكروا أنّ قتله× كان يوم السبت، فابتداء ذلك من هذا اليوم»[923].
2 ـ رواية رجل من أهل بيت المقدس
تقدّم ذكر هذه الرواية سابقاً، وقد أخرجها ابن قولويه بسنده إلى أبي نصر، عن رجل من أهل بيت المقدس في خبر طويل جاء فيه: «... وانكسفت الشمس ثلاثة أيام»[924].
وقد عرفنا سابقاً أنّ هذا السند ضعيف؛ لوجود عدّة مجاهيل فيه.
اتضح أنّ هذه الحادثة وردت بعدّة طرق عند أهل السنّة، بعضها صحيحة كخبر أبي قبيل، وخبر خليفة بن صاعد، كما أنّها وردت من طرق الشيعة أيضاً كما تقدّم.
غير أنّه لم يرد في خبر خليفة، وخبر أُمّ حيّان إشارة إلى كسوف الشمس، بل اقتصر الرواة على ذكر الظلام الذي حصل في الكون في ذلك اليوم، وكما قدّمنا سابقاً، فإنّ الظلام ملازم لانكساف الشمس، فالأظهر أنّ المراد من الأخبار هو شيء واحد.
ثمّ الظاهر أنّه يوجد غير أبي قبيل قد صرّح بالكسوف، وهو ما أشار إليه ابن حجر العسقلاني، حين ذكر خبر أبي قبيل في كسوف الشمس، وأوضح أنّ غير أبي قبيل رواه أيضاً، فقال: «روى البيهقي عن أبي قبيل وغيره أنّ الشمس كُسفت يوم قُتل الحسين»[925].
كما أنّ ابن عباس صرّح بالكسوف كما في خبر الصدوق والراوندي، وكذلك يزيد بن أبي زياد كما في خبر أبي الشيخ.
فاتّضح أنّ القدر المشترك من الخبر هو حصول ظاهرة الانكساف، وقد وردت في كتب الفريقين، ممّا يُشكّل قرينة أُخرى تقوّي مسألة الوثوق بحصول الحادثة.
كما أنّ هذه الحادثة تُعدُّ من المشهورات، وهو ما صرّح به الشربيني، حيث قال: «وكذا اشتهر أنّها كسفت يوم قُتل الحسين، وأنّه قُتل يوم عاشوراء»[926].
وأمّا ما يتعلّق بفترة الانكساف والاختلاف في ذلك فغير ضار بعد اتّفاق الأخبار على أصل ظاهرة الانكساف، ولربّما يكون منشأ الاختلاف راجع إلى اختلاف الأماكن، والله العالم.
عرفنا قبل قليل أنّ الأخبار تارةً ذكرت الظلام وأُخرى ذكرت الانكساف، فهل من الممكن حصول الانكساف حقيقة أَم الأمر لا يعدو حصول الظلام، وتوهم الرواة أنّ الشمس انكسفت؟
من المعروف علميّاً أنّ انكساف الشمس بمعنى حيلولة القمر بينها وبين الأرض لا يحصل إلّا في أواخر الشهور العربية، ولا يمكن حصول ذلك قبل يوم السابع والعشرين قطعاً، ومقتل الحسين× حصل في يوم العاشر من المحرّم فمن جهة علمية لا يمكن حصول الكسوف.
إلّا أنّه قد يقال بأنّنا ما دمنا نتكلّم عن حوادث إعجازية خارقة للعادة، فلا معنى للحساب العلمي، فكما أنّ مطر السماء دماً يُعتبر خارجاً عن الأُطر الطبيعية، فكذلك لتنكسف الشمس خارج الأُطر الطبيعية.
غير أنّ هذا الكلام مردود روائياً أيضاً، فقد ورد عن النبي’ أنّه لا تنكسف الشمس لموت أحد، رواه الكليني في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن سعيد، عن علي بن عبد الله، قال: «سمعت أبا الحسن موسى×، يقول: إنّه لمّا قُبض إبراهيم ابن رسول الله’ جرت فيه ثلاث سنن: أمّا واحدة، فإنّه لمّا مات انكسفت الشمس. فقال الناس: انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله. فصعد رسول الله’ المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: يا أيّها الناس، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان [له] لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته...»[927].
إلّا أنّ المجلسي يرى أنّ الرواية مختصّة بمحض الموت مالم ترافقه أسباب أُخرى، فقال فيها: «أي بمحض الموت، بل إذا كان ذلك بسبب فعل الأُمّة واستحقوا العذاب والتخويف يمكن أن ينكسفا لذلك، فلا ينافي ما رُوي في الأخبار من انكسافهما لشهادة الحسين (صلوات الله عليه)، ولعنة الله على قاتله، فإنّها كانت بفعل الأُمّة الملعونة، واستحقوا بذلك التخويف والعذاب بخلاف فوت إبراهيم×، فإنّه لم يكن بفعل الأُمّة»[928].
بينما يلتزم الشيخ حسن زادة آملي بالرواية دون تأويل، ويرى عدم تحقق الكسوف الحقيقي، فيقول: «لم يكن الانكساف على معناه الواقعي الحقيقي المعروف بين الناس، أعني: انكساف الشمس بحيلولة القمر بينها وبين الأرض؛ لمِا ثبت بالبرهان اليقيني الرياضي المبتني على الأرصاد من قديم الدهر إلى الآن، المعاضد بالمشاهدة أيضاً، من أنّ الشمس لا تنكسف إلّا في أواخر الشهور العربية، ولا يصادف الحيلولة قبل اليوم السابع والعشرين قطعاً، كما أنّ انخساف القمر يكون في أواسط الشهر فقط، ولا يقع قبل الليلة الثالثة عشر حتماً، فالانكساف في وقت اجتماعهما دائماً، والانخساف في استقبالهما كذلك، فإذا لم يكن انكسافها على معناه، فالجدير أن يقال أنّ الشمس أظلمت بتلك الواقعة الهائلة؛ لمِا دريت من أنّ للذنوب تأثيرات في تغيير الأحوال الكونيّة، وأمّا أنّ الشمس بماذا أظلمت حينئذٍ فعلمه مستور عنّا.
وقد روى الشيخ الأجل قطب الدين الراوندي& في آخر كتابه الخرائج والجرائح عن الإمام أبي جعفر الباقر×، قال: آيتان تكونان قبل قيام القائم لم يكونا منذُ هبط آدم إلى الأرض، تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر آخره، فعند ذلك يسقط حساب المنجّمين»[929].
والراجح عندنا من خلال ما قدّمناه وأوضحناه أنّ الكسوف حاصل، ولا معنى للتمسّك بالمعطيات العلمية مادام الكلام في حوادث وأُمور خارجة عن نواميس الطبيعة، وإذا أنكرنا الكسوف رغم دلالة الروايات عليه، فلا معنى أيضاً أنْ نتمسّك بالظلام ونقول إنّ سرّه مخفي، فهو خارج عن الأُطر الطبيعية أيضاً.
ثمّ إنّ كتب الفريقين صرّحت بانكساف الشمس لموت إبراهيم، وقد مات في اليوم العاشر أيضاً على ما سيأتي، أضف إلى ذلك، فإنّ العلماء يبحثون مسألة ما إذا اتّفق حصول الكسوف مع العيد، ومن المعلوم أنّ العيد إمّا يكون أوّل الشهر وهو عيد الفطر، أو عاشر الشهر وهو عيد الأضحى.
وكيف ما كان، فالحادثة حاصلة وما أبرزناه من كلمات لا يوجد فيها نفي للحادثة بقدر ما فيها توجيه للمراد، وهل أنّ الكسوف حصل أَم أنّ الدنيا أظلمت لأمر خفي غير الكسوف؟ وكلاهما يُعدّ حادثة كونية غير طبيعية، وهو المراد الأوّل من البحث كما لا يخفى.
وقد صرّح جملة من علماء أهل السنة بإمكانية حصول الكسوف في أوائل الشهر، عند بحثهم مسألة اجتماع العيد والكسوف:
قال ابن عابدين: «فإن قيل: كيف يجتمعان والكسوف في العادة لا يكون إلّا في آخر يوم من الشهر، والعيد أوّل يوم، أو يوم العاشر؟ قلنا: لا يمتنع، فقد رُوي أنّها كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وموته كان يوم العاشر من ربيع الأوّل»[930].
وقال الدسوقي: «استُشكل بأنّ أهل الهيئة أحالوا اجتماع العيد والكسوف؛ لأنّ الكسوف لا يكون إلّا في التاسع والعشرين من الشهر، والعيد إمّا أوّل يوم من الشهر، أو عاشره، والحاصل أنّهم يقولون: إنّ الكسوف سببه حيلولة القمر بيننا وبين الشمس، ولا تكون الحيلولة إلّا عند اجتماع القمر مع الشمس في منزلة واحدة، وفي عيد الفطر يكون بينهما منزلة كاملة ثلاث عشرة درجة، وفي عيد الأضحى نحو مائة وثلاثين درجة، وحينئذٍ فلا يتأتى اجتماع العيد والكسوف.
وردّ ابن العربي عليهم: بأنّ لله أنْ يخلق الكسوف في أيّ وقت شاء؛ لأنّ الله فاعل مختار، فيتصرف في كلّ وقت بما يريد.
وفي حاشية الرسالة لح: أنّ الرافعي نقل أنّ الشمس كسفت يوم مات الحسين، وكان يوم عاشوراء، وورد أنّها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، وكان موته في العاشر من الشهر عند الأكثر، وقيل: في رابعه، وقيل: في رابع عشره...»[931].
وقال النووي: «فرع: اعترضت طائفة على قول الشافعي: اجتمع عيد وكسوف. وقالت: هذا محال، فإنّ الكسوف لا يقع إلّا في الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين. فأجاب الأصحاب بأجوبة:
أحدها: أنّ هذا قول المنجمين، وأمّا نحن، فنجوّز الكسوف في غيرهما، فإنّ الله تعالى على كلّ شيء قدير. وقد نُقل مثل ذلك، فقد صحّ أنّ الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وروى الزبير بن بكار في (الأنساب): أنّه توفّي في العاشر من شهر ربيع الأوّل. وروى البيهقي مثله عن الواقدي.
وكذا اشتهر أنّ قتل الحسين (رضي الله عنه) كان يوم عاشوراء. وروى البيهقي عن أبي قبيل: أنّه لمّا قُتل الحسين، كسفت الشمس»[932].
ثالثاً: حيطان دار الإمارة تسايل دماً
أورده المزي، قال: قال أبو القاسم البغوي: «حدّثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد، قال: حدّثنا زيد بن الحباب، قال: حدّثني أبو يحيى مهدي بن ميمون، قال: سمعت مروان مولى هند بنت المهلّب، قال: حدّثني بواب عبيد الله بن زياد: أنّه لمّا جيء برأس الحسين، فوضع بين يديه، رأيت حيطان دار الإمارة تسايل دماً»[933].
وأخرجه من طريقه ابن عساكر[934]، وابن العديم[935].
وأورده الطبري في ذخائره عن مروان مولى هند بنت المهلّب، قال: «حدّثني بواب عبيد الله بن زياد: أنّه لمّا جيء برأس الحسين بين يديه رأيت حيطان دار الإمارة تسايل دماً. [وقال:] خرّجه ابن بنت منيع»[936]. وابن بنت منيع هو نفسه أبو القاسم البغوي.
وأورده الصالحي الشامي من طريق البغوي أيضاً، لكنّه ذكر أنّ الراوي المباشر هو أيوب بن عبيد الله[937]، وليس بواب عبيد الله، والظاهر أنّه تصحيف مخالف لبقيّة النقولات المتعدّدة عن بواب عبيد الله.
وهذا السند لا كلام فيه إلا من جهة الراوي المباشر، فأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان، ثقة[938]، وزيد بن الحباب وثقه جمع، وفيه كلام يسير[939]، وانتهى الذهبي إلى أنّه ثقة وغيره أقوى منه[940]، وأبو يحيى مهدي بن ميمون ثقة[941]، ومروان مولى هند بنت المهلّب ثقة[942]، ولم يبق سوى بواب عبيد الله بن زياد، فلم نعرفه، لكن أغلب الظن أنّه كان من أعداء أهل البيت باعتبار عمله لهذا الطاغية، ومع ذلك يروي هذا الخبر، ممّا يُعطي للخبر قوة.
خلاصة الحكم السندي على هذا الخبر
اتّضح أنّ هذا السند رجاله إلى الراوي المباشر كلّهم ثقات، إلّا أنّ بواب عبيد الله بن زياد مجهول لم نعرفه، لكن أغلب الظن أنّه كان من أعداء أهل البيت باعتبار عمله لهذا الطاغية، كما ذكرنا، وحينئذ، فلا موجب لكذبه في خبر على خلاف هواه ومصلحته، فروايته لهذا الخبر، تعطيه قوة، وتزيد من احتمالية مطابقته للواقع بنسبة كبيرة.
والورس (بفتح الواو وسكون الراء): «نبات كالسمسم ليس إلّا باليمن ...»[943].
وقد ورد هذا الخبر بلفظ (دماً) بدل رماداً عند أبي مخنف على ما أرسله عنه ابن شهر آشوب، حيث نقل عن أبي مخنف في رواية: «ولمّا قُتل الحسين صار الورس دماً»[944]. وعنه المجلسي[945]، والبحراني[946].
لكنّ الظاهر أنّه من خطأ النُّسّاخ، مع أنّ الخبر مرسل لا يعوّل عليه.
وقد ورد في تحوّله رماداً عدّة أخبار، منها:
أورده المزي، قال: «قال أبو بكر الحميدي: عن سفيان بن عيينة، عن جدّته أُمّ أبيه: «لقد رأيت الورس عاد رماداً، ولقد رأيت اللحم كأنّ فيه النار حين قُتل الحسين»[947].
ومن طريق الحميدي، أخرجه البيهقي، قال: أخبرنا أبو الحسين[948]، أخبرنا عبد الله[949]، حدّثنا يعقوب[950]، حدّثنا أبو بكر الحميدي به[951].
وبعدّة طرق أخرجه ابن عساكر عن أبي الحسين القطان بالسند السابق[952].
وأخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا سفيان، حدّثتني جدّتي أُمّ أبي، قال: رأيت الورس الذي أُخذ من عسكر الحسين صار مثل الرماد»[953].
وأخرجه أيضاً ابن العديم في بُغيته[954].
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «حدّثني أبي، قال: ذكر لسفيان جدّته، فقال: قالت ـ يعني يوم قُتل الحسين ـ: صار اللحم كذا، وصار الورس أسود»[955].
ومن الواضح صحة سند الخبر إلى جدّة سفيان، فرجال سند البيهقي إلى جدّة سفيان كلّهم من الثقات المعروفين، فأبو الحسين بن الفضل القطان مُجمع على ثقته[956]، وعبد الله بن جعفر بن درستويه ثقة أيضاً[957]، ويعقوب بن سفيان الفسوي حافظ ثقة معروف صاحب كتاب المعرفة والتاريخ وغيرها[958]، وأبو بكر الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، ثقة إمام، من أثبت الناس في سفيان بن عيينة[959].
وكذلك رجال الطبراني، فإنّ علي بن عبد العزيز هو البغوي الحافظ، شيخ الطبراني، وعمّ الحافظ المعروف عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال الدارقطني: «ثقة مأمون»[960]. وقال الذهبي: «ثقة، لكنّه يطلب على التحديث، ويعتذر بأنّه محتاج»[961].
وإسحاق بن إسماعيل هو الطالقاني، ثقة[962].
وكذلك سند عبد الله بن أحمد فهو يرويه عن أبيه أحمد بن حنبل الثقة الإمام الحافظ المعروف إمام المذهب.
وأمّا سفيان بن عيينة الذي تدور عليه الأسانيد فهو ثقة ثبت حافظ إمام[963].
لذا قال فيه الهيثمي في طريق الطبراني: «رواه الطبراني ورجاله إلى جدّة سفيان ثقات»[964].
لكن جدّة سفيان لم نقف على ترجمة لها، غير أنّ رواية البيهقي لها من دون إشارة إلى ضعف الخبر توجب القول بصحته، كما أوضحنا سابقاً من أنّ البيهقي التزم في كتبه بنقل الصحيح سوى ما أشار إليه وبيّن ضعفه.
أضف إلى ذلك فإنّ ابن عيينة من المُتقنيين ومن الذين يتحرون الأخبار، ومن الذين ثبت عنهم أنّهم لا يرسلون إلّا عن ثقة، كما أنّه لم يتوقف أحد في مشايخه إذا حدّث بالسماع[965].
فلا يبعد حينئذٍ القول بصحّة هذا السند، خصوصاً أنّه رواه عن جدّته التي عاصرها وعرفها، فمن المستبعد جدّاً أنْ يروي عنها هكذا خبر مع علمه بضعفها، فلا بدّ أنْ تكون ثقة عنده.
وقد ورد المعنى المتقدّم بلفظ آخر عن أُمّ عيينة أيضاً: أخرجه أبو نعيم، قال: «حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفر من أصله، ثنا محمود بن أحمد الفرج، ثنا محمد بن المنذر البغدادي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، ثنا سفيان بن عيينة، حدّثتني جدّتي أُمّ عيينة: أنّ حمالاً كان يحمل ورساً، فهوى قتل الحسين بن علي، فصار ورسه رماداً»[966].
ومن طريقه الخطيب[967]، وابن عساكر[968].
وأورده في تهذيب الكمال، قال: «وقال محمد بن المنذر البغدادي، عن سفيان بن عيينة: حدّثتني جدّتي أُمّ عيينة: أنّ حمّالاً كان يحمل ورساً، فهوى قتل الحسين، فصار ورسه رماداً»[969].
فهو طريق آخر إلى ابن عيينه مضافاً للطرق الصحيحة الثلاثة المتقدّمة، وليس فيه علّة ظاهرة سوى أنّ محمد بن المنذر، ذكره الخطيب وغيره ولم يذكروه بجرح ولا تعديل، وكان قد حدّث في أصفهان[970].
وبما تقدّم يتبيّن أنّ الخبر برواية سفيان عن جدّته يمكن القول باعتباره بلحاظ أمرين:
الأوّل: رواية البيهقي له وسكوته عنه.
الثاني: أنّه يمكن القول بوثاقة جدّة سفيان بناءً على تحرّي سفيان في النقل، وعدم إرساله إلّا عن الثقات، وعدم الوقوف على مشايخ ضعاف له ممّن حدّث عنهم، مع خصوصية كونه يروي عن جدّته أمر خارج عن نظم الكون الطبيعية.
أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا الفضل بن دكين، قال: حدّثنا عقبة بن أبي حفصة السلولي، عن أبيه، قال: إنْ كان الورس من ورس الحسين، ليقال به هكذا [أي: يُفرَك] فيصير رماداً»[971].
وأخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو محمد السلمي، أنا أبو بكر الخطيب (ح)، وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر، قالا: أنا أبو الحسين، أنا عبد الله، نا يعقوب، نا أبو نعيم، نا عقبة بن أبي حفصة السلولي، عن أبيه، قال: إن كان الورس من ورس الحسين، يقال به هكذا، فيصير رماداً»[972].
وأخرجه ابن العديم من طريق أبو الحسين بسنده ومتنه سواء[973].
وأخرجه الخوارزمي بسنده إلى يعقوب بن سفيان، وساقه بسنده ومتنه[974].
أمّا الفضل بن دكين، فهو حافظ ثقة ثبت[975].
وعقبة بن أبي حفصة السلولي، لعلّه عقبة بن إسحاق، بقرينة رواية أبي نعيم الفضل بن دكين عنه، فقد ذكر الرازي في الجرح والتعديل، عقبة بن إسحاق السلولي، وقال: «روى عن إسماعيل بن أبي خالد، وليث بن أبي سليم، وأبى شراعة، روى عنه ابن إدريس، وإسحاق بن منصور، وأبو نعيم، سمعت أبي يقول ذلك»[976].
فابن أبي حاتم لم يذكر فيه جرحاً لا تعديلاً، وبضميمة رواية ثلاثة من الثقات عنه، وهم عبد الله بن إدريس، والفضل بن دكين، وإسحاق بن منصور، فلا يبعد القول بوثاقته حينئذٍ، ولا أقل من كونه صدوقاً حسن الحديث.
أمّا أبو حفصة فلم يتبيّن لنا مَن هو، فلعلّه أبو حفصة مولى عائشة، وقد ذكره الرازي من دون جرح ولا تعديل[977].
والخلاصة: إنّ هذا السند ضعيف؛ لعدم الوقوف يقيناً على المراد من أبي حفصة، بل كذلك عدم الاطمئنان من كون عقبة بن أبي حفصة هو عقبة بن إسحاق.
لكن هذا لا يمنع من كون هذا الخبر التاريخي يُعتبر قرينة قوية تتقوّى به بقيّة الأخبار الدالة على حصول وتحقق الحادثة.
رواه عنه جرير بن عبد الحميد، وعن جرير روي بطريقين:
الأوّل: طريق يحيى بن معين، قال: «حدّثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، قال: قُتل الحسين بن علي ولي أربع عشرة سنة، وصار الورس الذي كان في عسكرهم رماداً، واحمرّت آفاق السماء، ونحروا ناقةً في عسكرهم، فكانوا يرون في لحمها النيران»[978].
وأخرجه من طريقه ابن عساكر[979]، والخوارزمي[980]، وأورده المزي في تهذيبه[981]، والذهبي في سيره[982].
والسند جيد كما تقدّم سابقاً، فجرير بن عبد الحميد ثقة، ويزيد أيضاً ثقة على كلام مرّ فيه مفصّلاً.
الثاني: أخرجه أبو نعيم الأصبهاني، قال: «حدّثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمود بن أحمد بن الفرج، ثنا محمد بن المنذر البغدادي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبي زياد، قال: شهدت مقتل الحسين بن علي، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فصار الورس في عسكرهم رماداً»[983].
وهذا الطريق إلى جرير فيه ضعف من جهة محمد بن المنذر البغدادي؛ إذ لم يرد فيه توثيق، فقد ذكره الخطيب وغيره، ولم يذكروه بجرح ولا تعديل، وكان قد حدّث في أصبهان[984].
وكيفما كان، فهو يُزيد الطريق السابق قوّةً ويؤكّد صحّة الطريق إلى يزيد بن أبي زياد.
كما أنّ الخبر ورد مرسلاً عند أبي الشيخ، فقد روى في كتاب (السنّة) كما نقله الزرندي في نظم درر السمطين، بسنده إلى يزيد بن أبي زياد، قال: «شهدت مقتل الحسين، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فصار الورس في عسكرهم رماداً، واحمرّت السماء لقتله، وانكسفت الشمس لقتله حتّى بدت الكواكب نصف النهار، وظنّ الناس أنّ القيامة قد قامت، ولم يُرفع حجر في الشام إلّا رؤىَ تحته دم عبيط»[985].
لكن من المؤسف أنّ كتاب السنّة لأبي الشيخ لم يصل إلينا، فلم نقف على سنده، فيكون الخبر مرسلاً.
خلاصة الحكم على حادثة تحوّل الورس رماداً
تبيّن أنّ هذه الحادثة رويت بطرق عدّة عن ثلاثة من الرواة، وهم: جدّة سفيان، ويزيد بن أبي زياد، وأبو حفصة السلولي، ومن حيث السند فخبر يزيد سنده جيد، وخبر جدّة سفيان يمكن المصير إلى قبوله، وخبر أبو حفصة يزيدهما قوّة، وفي الجملة فإنّ هذه الأخبار تتقوّى مع بعضها البعض.
وهذه الحادثة لا تخرج عن سياق الحوادث المتقدّمة، في أنّها تُبيّن الحزن الشديد الذي حلّ بالسماء والأرض على مقتل الحسين× بهذه الكيفية، وما رافقه من غضب إلهي على هؤلاء القوم؛ بحيث تغيّر العالم بأسره، وحتى نبات الورس الذي اصطحبوه معهم احترق وتحوّل إلى رماد.
خامساً: طبخوا الإبل فصارت مثل العلقم
وهذا الخبر ورد عند السنّة والشيعة باختلاف في اللفظ:
فأخرجه البيهقي، قال: «أخبرنا أبو الحسن[986]، أخبرنا عبد الله، حدّثنا يعقوب، حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زيد، قال: حدّثني حميد[987] بن مرّة، قال: أصابوا إبلاً في عسكر الحسين يوم قُتل، فنحروها وطبخوها، قال: فصارت مثل العلقم، فما استطاعوا أنْ يسيغوا منها شيئاً»[988].
ومن طريق البيهقي وغيره أخرجه ابن عساكر، وكذلك ابن العديم، لكنهما ذكرا أنّ الراوي المباشر هو جميل بن مرّة، وليس حميد بن مرّة[989].
وأورده المزي والذهبي وغيرهما، قالوا: «قال: حمّاد بن زيد، عن جميل بن مرّة...»[990].
وأورده السيوطي، قال: «وأخرج البيهقي عن جميل بن مرّة...»[991].
وأخرجه الخوارزمي بسنده إلى حمّاد بن زيد، عن جميل بن مرّة أيضاً[992].
وسند هذا الخبر إلى الراوي المباشر صحيح، رجاله كلّهم ثقات، وقد تقدّمت الإشارة إلى جميعهم سابقاً.
وأمّا الراوي المباشر، فهو جميل بن مرّة وليس حميد بن مرّة؛ ذلك أنّ كُتب التراجم ذكرت في شيوخ حمّاد بن زيد جميل بن مرّة، ولم يذكروا حميد بن مرّة، وكذلك فإنّ كلّ مَن نقل الرواية سواء من طريق البيهقي أو غيره إنّما ذكروا الرواية عن جميل بن مرّة، كابن عساكر، وابن العديم، والمزي، والذهبي، والسيوطي، وغيرهم.
وجميل بن مرّة ثقة، وثّقه النسائي[993]، ويحيى بن معين[994]، وذكره ابن حبّان في الثقات[995]، وتبعهم على توثيقه الذهبي[996]، وابن حجر[997].
فتبيّن أنّ هذا الخبر صحيح الإسناد.
قد اختُلف في هذه الرواية سنداً متناً، فقد أخرجها ابن الجوزي وكذلك سبطه من طريق عبد الوهاب بن المبارك[998]: «أنبأنا أبو الحسين بن عبد الجبار، أنبأنا الحسين بن علي الطناجيري، ثنا عمر بن أحمد بن شاهين، ثنا أحمد بن عبد الله بن سالم، ثنا علي بن سهل، ثنا خالد بن خداش، ثنا حمّاد بن زيد، عن جميل بن مرّة، عن أبي الوصي[999]، قال: نُحرت الإبل التي حُمل عليها رأس الحسين وأصحابه، فلم يستطيعوا أكلها، كانت لحومها أمرّ من الصبر»[1000].
فالاختلاف في السند وقع في الراوي المباشر، فهنا الراوي المباشر ليس جميل بن مرّة، بل رواه عن أبي الوضيء، والاختلاف في المتن وقع في أنّ رواية البيهقي عن جميل بن مرّة تحدّثت عن مطلق الإبل، ولم تقيّدها بالإبل التي حُمل عليها رأس الحسين× كما في هذه الرواية.
كما أنّ (أبو الوضيء) الراوي المباشر عند ابن الجوزي ثقة أيضاً[1001].
وقد ورد قريب منه عند الشيعة، فنقل ابن شهر آشوب مرسلاً، عن أبي مخنف في رواية: «لمّا دُخل بالرأس على يزيد، كان للرأس طيب قد فاح على كلّ طيب، ولمّا نحر الجمل الذي حُمل عليه رأس الحسين كان لحمه أمرّ من الصبر»[1002].
وأورده عنه المجلسي[1003]، والبحراني[1004].
وهذه الرواية مرسلة كما هو واضح.
لكن إنْ قلنا: إنّ رواية البيهقي هي المقدّمة على رواية ابن الجوزي، فهذه الرواية لا تنافيها؛ فرواية البيهقي نصّت على أنّهم أصابوا إبلاً في عسكر الحسين×، ولمّا طبخوها كانت كالعلقم، وهذه تنصّ على أنّهم نحروا الجمل الذي حُمل عليه رأس الحسين×، فكان لحمه أمرّ من الصبر، فهذا الجمل بالنتيجة هو أحد الإبل التي كانت في عسكر الحسين×، ولم يذكر أيّ من الخبرين متى كان النحر والطبخ، فمن غير المعلوم أنّه كان بعد الواقعة مباشرة، حتى يقال أنّ الرؤوس لم تُرفع على الجمال بعدُ، فربّما كان في اليوم الثاني أو الثالث أو بعدها، فيكون هذا الجمل هو من جملة تلك الإبل لا غير.
وإنْ كانت رواية ابن الجوزي هي المقدّمة، فمن الواضح أنّ مرسلة المناقب مؤيدة لها.
أمّا لماذا لا يمكن الجمع بين رواية ابن الجوزي ورواية البيهقي؛ فذلك لأنّها في الحقيقة رواية واحدة تدور على جميل بن مرّة، وليس هما روايتين.
والنتيجة أنّ بعض الأبل التي نُحرت كان لحمها أمرّ من الصبر، فسواء كانت التي رفع عليها رأس الحسين× أو غيرها ليس ذو فائدة إضافية، فالحادثة على كلّ حال تدخل ضمن الحوادث الخارجة عن الأُطر الطبيعية؛ ولذا لا منفعة كثيرة تحصل في الترجيح بين رواية البيهقي ورواية ابن الجوزي، إلّا في تحديد الراوي المباشر الذي روى الحادثة، فطبق رواية ابن الجوزي، فإنّ الراوي المباشر لا شكّ في معاصرته للحادثة؛ لأنّه كان معاصراً لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب× وسمع منه، وكان من فرسانه على شرطة الخميس[1005]، وحضر معه وقعة الخوارج بالنهروان[1006].
وأمّا طبق رواية البيهقي، فالراوي المباشر هو جميل بن مرّة، فقد يقال بعدم معاصرته؛ لأنّ وفاته كانت في سنة (121هـ)، ووقعة الطفّ كانت في سنة (61هـ).
لكن عند التأمّل، فالقول بالمعاصرة هو المتعيّن، فلو فرضنا أنّ عمره كان ثمانون سنة حين الوفاة، وهو عمر طبيعي للراوي آنذاك، فيكون عمره في واقعة الطفّ في حدود العشرين سنة، فهو معاصر للحادثة حينئذٍ.
فحيثُ إنّه روى خبراً يتعلّق بالحادثة، وإمكانية معاصرته لها حاصلة وطبيعية، فالنفي حينئذٍ يحتاج للإثبات، كأنْ نعلم أنّ وفاته كانت في سن مبكر ـ مثلاً ـ فيكون خبره منقطعاً، ومع عدم المعرفة بعمره الحقيقي، وإمكان المعاصرة باعتبار أنّ عمر الثمانين هو عمر طبيعي جدّاً، فيُعدّ خبره متّصلاً لا منقطعاً.
وقد نَضمُّ إلى ذلك قرينة احتمالية وليست قطعية، وهي من خلال ترجمة أبي الوضيء، فقد صرّحوا برواية جميل بن مرّة عنه، وذكروا كما تقدّم أنّه كان معاصراً لأمير المؤمنين×، وكان على شرطته، وقد اشترك في بعض حروبه، ممّا قد يولّد انطباعاً أنّه كان كبير السن في تلك المدّة؛ بحيث صار قائداً لشرطة الخميس، فقد تكون وفاته حينئذٍ بعد عاشوراء بمدّة قليلة، ويترتب على ذلك أنّ رواية جميل بن مرّة عنه توجب معاصرة جميل لحادثة عاشوراء، وأنّ ولادته كانت سابقة لذلك؛ ليتمكّن من الرواية عنه.
إلّا أنّ هذه قرينة احتمالية كما أسلفنا، فقد يكون أبو الوضيء توفّيَ وهو في سن متقدّم أيضاً.
وكيف ما كان، فظاهر الرواية هو معاصرة الراوي للحادثة ولا يوجد ما ينفي ذلك.
وأمّا ما يمكن أنْ نستفيده من هذا الخبر، فمن الواضح أنّه يحمل في طياته عدّة من الدلالات أبرزها:
إنّ الحادثة تُعدُّ نوعاً من الغضب الإلهي على قتلة الحسين×، ونوعاً من العقاب لهم؛ بحيث إنّ هذه الأبل لم يهنأوا بها، بل كان طعمها شديد المرورة مثل العلقم.
وسيأتي التكلّم عن الدلالات العامّة المشتركة في كلّ الحوادث في الفصل الأخير إنْ شاء الله.
سادساً:تحوّل التربة إلى دم عبيط
وهذه الروايات وردت من طرق ووجوه عديدة عند الشيعة والسنّة:
أوّلاً: الروايات من طرق الشيعة
وهي قسمان: يتضمّن الأوّل: إخبارات النبي’ بأنّ من علامات قتل الحسين× هي تحوّل تربته إلى دم، وأمّا الثاني: فهي ما تضمّنت تحقق حادثة تحوّل التربة إلى دم، وكلاهما يصبّان في مجرى واحد، فإنّ إخبار النبي’ ـ باعتبار ما أطلعه الله على الغيب ـ لا يمكن أنْ يتخلّف، فمجرد ثبوت إخباره يثبت تحقق تلك الواقعة حتى لو لم تصل لنا أخبار في تحققها خارجاً.
ومثل هذه الإخبارات خارجة عن دائرة البداء؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى تكذيب النبي’ وعدم الوثوق بإخباره.
وأمّا الموارد التي أخبر فيها صلوات الله عليه وآله، ولم يتحقق ما أخبر به، كإخباره بموت اليهودي[1007] في وقت معيّن ولم يتحقّق؛ فإنّه لا يستلزم عدم الوثوق به’؛ وذلك لأنّه صلوات الله عليه وآله جاء بالشاهد والدليل على صدق دعواه حينما كشف للناس وأراهم الإفعى التي كان يحملها اليهودي..
خصوصاّ أنّ الفترة الزمنية بين الإخبار وإقامة الدليل على صدق إخباره’ لا تتجاوز اليوم الواحد، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ إخباره’ بتحول التربة يتعلّق بفترة ما بعد وفاته؛ الأمر الذي يتعذر معه إقامة الشاهد على صدق دعواه فيما لو حصل البداء.
والغرض أنّنا سنورد هنا ما وقفنا عليه من روايات سواء كانت إخبارية عن النبي’، أو التي تتضمّن حصول الحادثة:
أخرجها الطوسي، قال: «أخبرنا ابن خشيش، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن سعيد أبو العباس الهمداني، قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله الخصاف النحوي، قال: حدّثنا محمد بن سلمة بن أرتبيل، قال: حدّثنا يونس بن أرقم، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أنس بن مالك: أنّ عظيماً من عظماء الملائكة استأذن ربّه (عزّ وجلّ) في زيارة النبي’ فأذن له، فبينما هو عنده إذ دخل عليه الحسين×، فقبّله النبي’ وأجلسه في حجره، فقال له الملك: أتحبّه؟ قال: أجل أشدّ الحبّ، إنّه ابني. قال له: إنّ أُمّتك ستقتله. قال: أُمّتي تقتل ابني هذا؟! قال: نعم، وإنْ شئت أريتك من التربة التي يُقتل عليها. قال نعم. فأراه تربة حمراء طيبة الريح، فقال: إذا صارت هذه التربة دماً عبيطاً فهو علامة قتل ابنك هذا. قال سالم بن أبي الجعد: أُخبرت أنّ الملك كان ميكائيل×»[1008].
أمّا ابن خشيش، فتقدّم سابقاً أنّه ثقة من أبناء العامّة.
ومحمد بن عبد الله، هو أبو المفضّل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن المطلب الشيباني، مختلف فيه، قال فيه الطوسي: «كثير الرواية، حسن الحفظ، غير أنّه ضعّفه جماعة من أصحابنا»[1009].
وقال النجاشي: «وكان في أوّل أمره ثبتاً ثمّ خلط، ورأيت جلّ أصحابنا يغمزونه ويُضعّفونه... رأيت هذا الشيخ، وسمعت منه كثيراً، ثمّ توقفت عن الرواية عنه إلّا بواسطة بيني وبينه»[1010].
فمن غير الواضح أنّ الشيخ الطوسي يرى تضعيفه مع تصريحه بأنّه حسن الحفظ، كما أنّ النجاشي يرى أنّه كان ثبتاً ثمّ خلط، وعند معرفة أنّ الرجل توفّيَ وله (90) عاماً[1011]، فلربما يكون المراد بالخلط هو التغيّر بالحفظ، ومعه سيكون الرجل حسن الحديث، خصوصاً أنّه أكثر عنه الخزاز القمي مترحماً عليه؛ قال النمازي: «نقل العلامة المامقاني تضعيفه في آخر عمره عن جماعة، ثم قال: ونقل المولى الوحيد في فصل الكنى في ترجمة أبى المفضل الشيباني، أنّه أكثر الثقة الجليل علي بن محمد الخزاز من ذكره مترحماً عليه في كتابه الكفاية (يعنى كفاية الأثر) قال: ويظهر منه أنه شيخه، وحينئذ فيكون الرجل من الحسان» [1012].
وعدّه الشيخ الزنجاني من أعاظم المشايخ، ثقة جليل[1013].
وأحمد بن محمد بن سعيد، هو الحافظ ابن عقدة، وأمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر[1014].
وإبراهيم بن عبد الله الخصاف النحوي، قال فيه الزنجاني: «إبراهيم بن عبد الله الخصاف النحوي، أبو إسحاق، وقع في الطرق، وفي طريق النجاشي إلى محمد بن الحسن الرواسي، يروي عن خلّاد بن عيسى وغيره، روى عنه ابن عقدة، وجعفر بن محمد بن الليث، وظاهر النجاشي الاعتماد عليه، وحديثه جيد»[1015].
ومحمد بن سلمة بن أرتبيل، ثقة جليل القدر فقيه[1016].
ويونس بن أرقم، مجهول لم يذكروه، لكن ترجمه الزنجاني، وقال: «وأحاديثه جيّدة»[1017].
الأعمش، هو سليمان بن مهران، ثقة جليل القدر من خواص الإمام الصادق×[1018].
سالم بن أبي الجعد، ثقة، من خواص أمير المؤمنين[1019].
أمّا أنس بن مالك، فهو من الصحابة، وإنْ كان موقفه من أمير المؤمنين× سيئاً؛ إذ ورد أنّه كتم الشهادة في حديث الغدير، ودعا عليه الأمير حين ذاك، إلّا أنّ روايته هذه الخبر تُعدُّ قرينة على صدقه فيه، إذ ليس فيها ما يدعو إلى أنْ يقول خلاف الحقيقة، ويخترع هذه الحادثة الكونية من قِبله، فإنّ المناسب بلحاظ سوء موقفه مع أمير المؤمنين× أنْ ينفي هذه الأُمور عن البيت العلوي، لا أنْ يثبتها من عنده.
والخلاصة: إنّ السند من جهة أنس لا شائبة فيه بنظرنا، لكن تبقى مشكلة جهالة يونس بن أرقم لا غير، وبناءً على ما ذكره الشيخ الزنجاني من أنّ أحاديث يونس جيّدة، سيكون سند هذا الحديث جيد معتبر.
2 ـ رواية أبي الجارود عن الباقر ×
أخرجها الصدوق، قال: «حدّثنا أبي&، قال: حدّثنا حبيب بن الحسين التغلبي، قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر×، قال: كان النبي’ في بيت أُمّ سلمة (رضي الله عنها)، فقال لها: لا يدخل علي أحد.
فجاء الحسين× وهو طفل، فما ملكت معه شيئاً حتى دخل على النبي’، فدخلت أُمّ سلمة على أثره، فإذا الحسين على صدره، وإذا النبي’ يبكي، وإذا في يده شيء يقلّبه، فقال النبي’: يا أُمّ سلمة، إنّ هذا جبرئيل يُخبرني أنّ هذا مقتول، وهذه التربة التي يُقتل عليها، فضعيها عندك، فإذا صارت دماً فقد قُتل حبيبي. فقالت أُمّ سلمة: يا رسول الله، سلْ الله أن يدفع ذلك عنه. قال: قد فعلت، فأوحى الله (عزّ وجلّ) إليّ: أنّ له درجة لا ينالها أحد من المخلوقين، وأنّ له شيعة يَشفعون فيُشفّعون، وأنّ المهدي من ولده، فطوبى لـمَن كان من أولياء الحسين، وشيعته هم ـ والله ـ الفائزون يوم القيامة»[1020].
خلاصة الحكم السندي على هذه الرواية
هذه الرواية ضعيفة من حيث السند؛ فحبيب بن حسين التغلبي مجهول، وأبو الجارود فيه كلام كثير، والأكثر على تضعيفه، غير أنّ السيّد الخوئي يرى وثاقته[1021].
إلا أنّ الضعف السندي لا يعني عدم تحقق تلك الحادثة؛ ذلك لورود الحادثة من طرق أُخرى في كتب الفريقين كما سيأتي، وقد تقدّمت رواية أنس وليس فيها علّة كما ذكرنا.
3 ـ رواية عبد الله بن عباس، عن أُمّ سلمة، والباقر×، عن عمر بن أبي سلمة، عن أُمّه أُمّ سلمة
أخرجها الشيخ الطوسي، قال: «أخبرنا ابن خشيش، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله، قال: حدّثنا علي بن محمد بن مخلّد الجعفي من أصل كتابه بالكوفة، قال: حدّثنا محمد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدي، قال: حدّثني غوث بن مبارك الخثعمي، قال: حدّثنا عمرو بن ثابت، عن أبيه أبي المقدام، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، قال: بينا أنا راقد في منزلي إذ سمعت صراخاً عظيماً عالياً من بيت أُمّ سلمة زوج النبي’، فخرجت يتوجّه بي قائدي إلى منزلها، وأقبل أهل المدينة إليها الرجال والنساء، فلمّا انتهيت إليها قلت: يا أُمّ المؤمنين، ما بالك تصرخين وتغوثين؟ فلم تجبني، وأقبلت على النسوة الهاشميات، وقالت: يا بنات عبد المطلب، اسعدنني وابكين معي، فقد والله قُتل سيّدكن وسيّد شباب أهل الجنّة، قد والله قُتل سبط رسول الله وريحانته الحسين. فقيل: يا أُمّ المؤمنين، ومن أين علمت ذلك؟ قالت: رأيت رسول الله’ في المنام الساعة شعثاً مذعوراً، فسألته عن شأنه ذلك، فقال: قُتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم، فدفنتهم، والساعة فرغت من دفنهم. قالت: فقمت حتى دخلت البيت، وأنا لا أكاد أن أعقل، فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرئيل من كربلاء، فقال: إذا صارت هذه التربة دماً، فقد قُتل ابنك. وأعطانيها النبي’. فقال: اجعلي هذه التربة في زجاجة ـ أو قال: في قارورة ـ ولتكن عندك، فإذا صارت دماً عبيطاً، فقد قُتل الحسين. فرأيت القارورة الآن وقد صارت دماً عبيطاً تفور. قال: وأخذت أُمّ سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجهها، وجعلت ذلك اليوم مأتماً ومناحةً على الحسين×، فجاءت الركبان بخبره، وأنّه قُتل في ذلك اليوم.
قال عمرو بن ثابت، قال أبي: فدخلت على أبي جعفر محمد بن علي× منزله، فسألته عن هذا الحديث، وذكرت له رواية سعيد بن جبير هذا الحديث، عن عبد الله بن عباس، فقال: أبو جعفر×: حدّثنيه عمر بن أبي سلمة، عن أُمّه أُمّ سلمة.
قال ابن عباس: في رواية سعيد بن جبير عنه، قال: فلمّا كانت الليلة رأيت رسول الله’ في منامي أغبر أشعث، فذكرت له ذلك وسألته عن شأنه. فقال لي: ألم تعلم أنّي فرغت من دفن الحسين وأصحابه؟!
قال عمرو بن أبي المقدام: فحدّثني سدير، عن أبي جعفر×: أنّ جبرئيل جاء إلى النبي’ بالتربة التي يُقتل عليها الحسين×، قال أبو جعفر: فهي عندنا»[1022].
أمّا ابن خشيش، ومحمد بن عبد الله، فقد تقدّم الكلام عنهما، والأوّل ثقة، والثاني مختلف فيه، وعرفنا أنّ بعضهم انتهى إلى حسن حديثه، بل وثقه الزنجاني على ما مر.
علي بن محمد بن مخلّد الجعفي، لم يذكروه، وله كتاب، وهذه الرواية من أصل كتابه.
ومحمد بن سالم بن عبد الرحمن الأزدي، مجهول.
وغوث بن مبارك الخثعمي، لم يذكروه.
وعمرو بن ثابت، ثقة عند جملة من العلماء[1023].
وأبو المقدام، ثابت بن هرمز، مختلف فيه، ووثقه السيّد الخوئي بناءً على وروده في تفسير القمي[1024].
وسعيد بن جبير، تابعي من الأجلّاء[1025].
وعبد الله بن عباس، صحابي ثقة جليل القدر[1026].
وكما عرفنا فإنّ عمرو بن ثابت له طريق آخر، فقد رواها عن أبيه، عن الباقر، عن عمر بن أبي سلمة، عن أُمّ سلمة.
فلا إشكال في الطريق بين عمرو بن ثابت وأُمّ سلمة، إلّا أنّ الطريق إلى عمرو فيه ثلاثة من المجاهيل.
والخلاصة: إنّ الرواية ضعيفة؛ لجهالة ثلاثة من الرواة.
تنويه: أورد هذا الخبر ابن شهر آشوب في مناقبه باختلاف يسير في اللفظ، وذكر أنّه رواه عن الغزالي في كيمياء السعادة، وابن بطة في كتاب الإبانة من خمسة عشر طريقاً، وابن حبيش التميمي واللفظ له، قال ابن عباس: وذكره[1027].
فإنْ تمّ ما ذكره ولم يكن من سهو القلم، فستكون الرواية مرويّة بخمسة عشر طريقاً، وهذا المقدار يحقّق الاستفاضة الموجبة للاطمئنان.
4 ـ رواية أُخرى مرسلة عن الباقر×
كما أنّ الخبر عن الإمام الباقر×، عن أُمّ سلمة (رضي الله عنها)، ورد مرسلاً في كتاب الثاقب في المناقب بألفاظ مختلفة، وبقصة أُخرى تختلف عن سابقتها، حصلت لأُمّ سلمة مع الإمام الحسين×، وفيها تُخبر أُمّ سلمة الإمام الحسين× بالتربة التي أودعها إيّاها الرسول’، كما أنّ الخبر فيه تكملة بأنّ الحسين× أيضاً أعطاها من تلك التربة فمزجتهما معاً، وأنّ أُمّ سلمة رأت بأنّ ما في القارورة قد تحوّل دماً عند مقتل الحسين×، فقد جاء في الخبر:
عن الباقر (صلوات الله عليه)، قال: «لمّا أراد الحسين (صلوات الله عليه) الخروج إلى العراق، بعثت إليه أُمّ سلمة (رضي الله عنها)، وهي التي كانت ربته، وكان أحبّ الناس إليها، وكانت أرق الناس عليه، وكانت تربة الحسين عندها في قارورة دفعها إليها رسول الله’.
فقالت: يا بني، أتُريد أنْ تخرج؟ فقال لها: يا أُمّه، أُريد أنْ أخرج إلى العراق.
فقالت: إنّي أذكرك الله تعالى أنْ تخرج إلى العراق. قال: ولِمَ ذلك يا أُمّه؟
قالت: سمعت رسول الله’ يقول: يُقتل ابني الحسين بالعراق. وعندي يا بني تربتك في قارورة مختومة دفعها إليّ رسول الله’.
فقال: يا أُمّاه والله، إنّي لمقتول، وإنّي لا أفرّ من القدر والمقدور، والقضاء المحتوم، والأمر الواجب من الله تعالى.
فقالت: وا عجباه، فأين تذهب وأنت مقتول؟
فقال: يا أُمّه، إنْ لم أذهب اليوم ذهبت غداً، وإنْ لم أذهب غداً لذهبت بعد غد، وما من الموت ـ والله يا أُمّه ـ بُد، وإنّي لأعرف اليوم والموضع الذي أُقتل فيه، والساعة التي أُقتل فيها، والحفرة التي أُدفن فيها، كما أعرفك، وأنظر إليها كما أنظر إليك.
قالت: قد رأيتها؟! قال: إنْ أحببت أنْ أريك مضجعي ومكاني، ومكان أصحابي فعلت. فقالت: قد شئتها.
فما زاد أنْ تكلّم بسم الله، فخُفضت له الأرض حتّى أراها مضجعه ومكانه، ومكان أصحابه، وأعطاها من تلك التربة، فخلطتها مع التربة التي كانت عندها، ثمّ خرج الحسين (صلوات الله عليه)، وقد قال لها: إنّي مقتول يوم عاشوراء.
فلمّا كانت تلك الليلة التي صبيحتها قُتل الحسين بن علي (صلوات الله عليهما) فيها، أتاها رسول الله’ في المنام أشعث باكياً مغبراً، فقالت: يا رسول الله، مالي أراك باكيا مغبراً أشعث؟ فقال: دفنت ابني الحسين×، وأصحابه الساعة.
فانتبهت أُمّ سلمة (رضي الله عنها)، فصرخت بأعلى صوتها، فقالت: وا ابناه. فاجتمع أهل المدينة وقالوا لها: ما الذي دهاك؟
فقالت: قُتل ابني الحسين بن علي (صلوات الله عليهما). فقالوا لها: وما علمك [بذلك]؟
قالت: أتاني في المنام رسول الله (صلوات الله عليه) باكياً أشعث أغبر، فأخبرني أنّه دفن الحسين وأصحابه الساعة. فقالوا: أضغاث أحلام. قالت: مكانكم، فإنّ عندي تربة الحسين×، فأخرجت لهم القارورة، فإذا هي دم عبيط»[1028].
لكن الخبر مرسل، والمرسل محكوم بالضعف.
وبنحو آخر أرسل الراوندي في خرائجه هذا الخبر عن أُمّ سلمة مع اختلاف واختصار في الحادثة على ما يبدو، فقد جاء فيه: «أنّ الإمام الحسين× لمّا أراد الخروج، قالت له أُمّ سلمة: لا تخرج إلى العراق، فقد سمعت رسول الله’، يقول: يُقتل ابني الحسين ب [أرض] العراق، وعندي تربة دفعها إليّ في قارورة.
فقال: والله إنّي مقتول كذلك، وإنْ لم أخرج إلى العراق يقتلونني أيضاً، وإنْ أحببت أنْ أُريكِ مضجعي، ومصرع أصحابي. ثمّ مسح بيده على وجهها، ففسح الله في بصرها حتّى أراها ذلك كلّه، وأخذ تربة فأعطاها من تلك التربة أيضاً في قارورة أُخرى، وقال×: فإذا فاضتا دماً، فاعلمي أنّي قد قُتلت.
فقالت أُمّ سلمة: فلمّا كان يوم عاشوراء نظرت إلى القارورتين بعد الظهر فإذا هما قد فاضتا دماً، فصاحت»[1029].
والرواية مرسلة أيضاً، وبنحوها روى علي بن يونس العاملي مرسلاً عن أُمّ سلمة أيضاً[1030].
قال الشيخ المفيد: وروي بإسناد آخر عن أُمّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ أنّها قالت: «خرج رسول الله’ من عندنا ذات ليلة، فغاب عنّا طويلاً، ثمّ جاءنا وهو أشعث أغبر ويده مضمومة، فقلت: يا رسول الله، ما لي أراك شعثاً مغبراً ؟! فقال: أُسري بي في هذا الوقت إلى موضع من العراق يقال له كربلاء، فأُريت فيه مصرع الحسين ابني وجماعة من ولدي وأهل بيتي، فلم أزل ألقط دماءهم فها هي في يدي، وبسطها إليّ فقال: خذيها واحتفظي بها، فأخذتها فإذا هي شبه تراب أحمر، فوضعته في قارورة وسددت رأسها واحتفظت به، فلمّا خرج الحسين× من مكّة متوجهاً نحو العراق، كنت أخرج تلك القارورة في كلّ يوم وليلة فأشمّها وأنظر إليها، ثمّ أبكي لمصابه، فلمّا كان في اليوم العاشر من المحرّم ـ وهو اليوم الذي قُتل فيه× ـ أخرجتها في أوّل النهار وهي بحالها، ثمّ عدت إليها آخر النهار، فإذا هي دم عبيط، فصحتُ في بيتي وبكيت، وكظمت غيظي؛ مخافة أنْ يسمع أعداؤهم بالمدينة، فيسرعوا بالشماتة، فلم أزل حافظة للوقت حتّى جاء الناعي ينعاه، فحقق ما رأيت»[1031].
6 ـ رواية الطبري الشيعي عن أُمّ سلمة
وأرسله الطبري الشيعي، عن أُمّ سلمة بلفظ: «إنّ أُمّ سلمة أخرجت يوم قُتل الحسين بكربلاء، وهي بالمدينة قارورة فيها دم، فقالت: قُتل والله الحسين. فقيل لها: من أين علمتِ؟ قالت: دفع إليّ رسول الله من تربته، وقال لي: إذا صار هذا دماً فاعلمي أنّ ابني قد قُتل، فكان كما قال»[1032].
فالرواية من جهة السند محكومة بالضعف أيضاً.
وبهذا يتضّح أنّ آحاد إسناد هذه الروايات ضعيفة، لكنّها روايات متعدّدة مسنودة بروايات أُخرى من طرق أهل السنّة، وهذا ما يعزّز تحقق الحادثة واقعاً.
تأمّلات في رواية التربة من طرق الشيعة
1 ـ عند التأمّل في الروايات أعلاه نجد أنّ الروايات المسندة ثلاث روايات، وأمّا البقيّة فمرسلات، لكن متونها مختلفة عن بعضها، ممّا يدلّل على أنّهنّ لسن رواية واحدة، بل هناك رواة مختلفين لكلّ واحدة منهنّ، ولذا اختلف النقل، والتعدّد في النقل يعزز من ثبوت الحادثة.
2 ـ من الواضح أنّ هناك اختلافاً في متون الروايات المتقدّمة، وهو ملخص بالشكل التالي:
أ ـ اقتصرت الرواية الأُولى على إخبار المَلَك للنبي’، بأنّ أُمّته ستقتل ولده الحسين، وناوله من تربته، وكشف له عن علامة قتله، قال: «إذا صارت هذه التربة دماً عبيطاً، فهو علامة قتل ابنك هذا».
ولم تتعرّض هذه الرواية إلى تحقق أو حصول تلك الحادثة، لكن حيث إنّ المُخبر هو الملك المعصوم من السماء، وكان الغرض هو كشف الأُمور المستقبلية للنبي’، فكان لا بدّ من تحقق هذا الإخبار ولزوم حصوله، فهو لا يتنافى مع ما دلّ على حصوله ووقوعه، بل كلاهما يصبّان في معنى واحد.
ب ـ إنّ الرواية الثانية جاءت مكمّلة للرواية الأُولى وتصبّ في بوتقتها، فبعد أنْ اطّلع النبي’ على أسرار السماء بواسطة الملك، جاء وأخبر أُمّ سلمة بما كشفه الله له من الغيب، فقال لها: «إنّ هذا جبرئيل يُخبرني أنّ هذا مقتول، وهذه التربة التي يُقتل عليها، فضعيها عندك، فإذا صارت دماً، فقد قُتل حبيبي». وبهذا يكون السرّ السماوي قد وصل إلى الأرض في عملية تمهيد واستعداد لمِا سيحصل من مأساة إنسانية، يكون ضحيتها ابن الرسول الأكرم’.
جـ ـ إنّ الرواية الثالثة جاءت لتُكمل دور الروايتين الأوّليتين لتعرض أمامنا قصّة التحقّق، ووقوع الإخبار، وحصول الحادثة، فقد حان الوقت لتتحول تلك التربة الطاهرة إلى دم عبيط؛ لتؤذن بدخول عهد جديد في الإسلام، فقد احتوشت سيوف الغدر ذلك الجسد الطاهر، ولم يراعوا له إلّاً ولا ذمّة، فارتعد الكون بأسره، فما كان من أُمّ سلمة إلّا النوح واللطم والبكاء، فاجتمع عليها أهل المدينة، وفي مقدّمتهم ابن عباس، فحدّثتهم بما أخبر به النبي’، وبما تحقق في ذلك اليوم.
إذن فالروايات الأُولى والثانية والثالثة يصدّق بعضها بعضاً، وهي سلسلة من الأخبارات يكمّل بعضها البعض الآخر.
د ـ إنّ بعض المتون حصل فيها اختلاف شديد، فمثلاً: في رواية ابن عباس أنّ أُمّ سلمة رأت النبي’ في المنام أشعث أغبر، وأخبرها بقتل الحسين×، ففزعت وذهبت للقارورة، فرأتها تحوّلت دماً، فعرفتْ بمقتل الحسين×، وقريب من هذا ما ورد في المرسل عن الباقر×، الواردة في الثاقب في المناقب.
لكن رواية الشيخ المفيد تُعطي معنى آخر، وتختلف عن بقيّة الروايات بثلاثة أُمور:
الأوّل: تضمّنت الرواية أنّ النبي’ أُسري به إلى كربلاء، والتقط دم الحسين× وأصحابه وأعطاه لأُمّ سلمة، فكانت شبه التراب الأحمر، ولم تتضمّن أنّ هناك ملكاً أتى إلى النبي’ وأخبره بقتل الحسين× وناوله التراب.
الثاني: إنّ أُمّ سلمة كانت تتفقد القارورة باستمرار صباحاً ومساءً، وفي يوم عاشوراء رأتها أوّل النهار فلم تتغيّر، ثمّ رأتها آخر النهار فوجدتها متغيّرة، فعلمت بمقتل الحسين×، وهذا يعني أنّها لم ترَ في المنام أنّ النبي’ أشعث أغبر، وأخبرها بقتل الحسين×، ثمّ توجهت للتربة، بل إنّها تفقدت التربة في آخر النهار ووجدتها قد تغيّرت.
الثالث: إنّ أُمّ سلمة لم تصرخ وتعول، ولم يجتمع الناس عندها، بل كتمت غيظها؛ مخافة أنْ يسمع الأعداء بها فيشمتوا، بخلاف ما تقدّم من صريخها واجتماع الناس لديها بما فيهم ابن عباس وقائده.
والخلاصة: إنّ رواية الشيخ المفيد تسوق الأحداث بنحو جديد آخر يختلف عن رواية ابن عباس، وعن المرسل عن الباقر×، لكنّها تتفق معهن بالنتيجة، وهي: إنّ التربة تحوّلت إلى دم أحمر يوم عاشوراء.
فإنْ كان هذا الاختلاف موجب لرفع اليد عن أحد القسمين من هذه الروايات، فلا شكّ في أنّنا سوف نرفع اليد عن رواية الشيخ المفيد؛ لأنّها مرسلة أوّلاً، واحتواء متنها على غرابة من جهة إسراء النبي’؛ حيث إنّ الروايات عديدة من الفريقين تؤكد نزول الملك عليه، وإعطائه من تربة كربلاء، ومن جهة كتمان أُمّ سلمة غيظها خوفاً من شماتة الأعداء، فهذا بعيد أيضاً، ومن غير المتصوّر أنّ أُمّ سلمة مع معرفتها بقدر الحسين× وقيمته، ومعرفتها بإخبار النبي’ عن قتله، ورؤيتها للتراب المتحوّل دماً، ومع ذلك تكتم الخبر ولا تصرخ ولا تعول، لا لشيء سوى الخوف من شماتة الأعداء، كما أنّ المدينة مليئة بدور بني هاشم والعلويين، ومن المستبعد أنْ يجرأ أحد ويشمت بهم لمقتل الحسين×.
والخلاصة: إنْ قلنا ـ كما هو غير بعيد ـ بأنّه يمكن التمسك بالقدر المشترك من الروايات، وهو تحوّل التربة إلى دم فبه، وإلّا فتطرح رواية الشيخ المفيد لا غير.
وأمّا رواية الطبري فقد احتوت على إضافة جديدة، وليس فيها ما يتنافى مع رواية ابن عباس ومرسلة الباقر×، فقد تضمّنت أنّ الحسين× أيضاً أعطاها من تربة كربلاء، وأنّها وضعت كلّ تربة في قارورة، وأمّا باقي الأحداث فهي متقاربة.
والنتيجة: نحن ذكرنا ست روايات، ثلاث منها مسندة وثلاث منها مرسلة، والمسندات فيهما اثنتان نصتا على الإخبار بأنّ التربة ستتحوّل إلى دم، والثالثة تناولت تحقق الواقعة في يوم عاشوراء.
والمرسلات كلّها تحدّثت عن تحقق الواقعة بصور لا تخلو من الاختلاف، بل زادت سعة الاختلاف في رواية الشيخ المفيد، مع اتفاق الكلّ على تحوّل التربة إلى دم في يوم عاشوراء.
وهذا المعنى حيث إنّه ورد بهذا العدد في كتب الشيعة، وورد أيضاً بطرق ومضامين متعددة عند أهل السنّة، فلا يبعد حدوثه واقعاً؛ إذ إنّ الاتفاق لا يمكن حصوله في هكذا أُمور حساسة إذا لم يكن لها أصل.
1 ـ رواية أبي وائل عن أُمّ سلمة
أخرجها الطبراني، قال: «حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدّثني عبّاد بن زياد الأسدي، ثنا عمرو بن ثابت، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن أُمّ سلمة، قالت: كان الحسن والحسين (رضي الله عنهما) يلعبان بين يدي النبي (صلّى الله عليه وسلّم) في بيتي، فنزل جبريل×، فقال: يا محمد، إنّ أُمّتك تقتل ابنك هذا من بعدك. فأومأ بيده إلى الحسين، فبكى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وضمّه إلى صدره، ثمّ قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): وديعة عندك هذه التربة، فشمّها رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وقال: ويح كرب وبلاء. قالت: وقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): يا أُم سلمة، إذا تحوّلت هذه التربة دماً، فاعلمي أنّ ابني قد قُتل. قال: فجعلتها أُمّ سلمة في قارورة، ثمّ جعلت تنظر إليها كلّ يوم وتقول: إنّ يوماً تُحَوّلين دماً ليوم عظيم»[1033].
ومن طريق الطبراني أخرجها ابن عساكر[1034]، وابن العديم[1035].
وأوردها المزي في التهذيب[1036]، والهيثمي في المجمع[1037]، وغيرهم كُثُر.
وقد روى الزرندي الحنفي تتمّة لتلك الرواية، فقال: فقالت أُمّ سلمة: «فأخذته، فجعلته في قارورة، فأصبته يوم قُتل الحسين وقد صار دماً»[1038].
أمّا عبد الله بن أحمد، فثقة ثبت معروف، وعبّاد بن زياد الأسدي، قال فيه أبو داوُد: صدوق، وروى عنه عدّة من الثقات والمحدّثين[1039]، وقال ابن حجر: «صدوق، رُمي بالقدر والتشيّع»[1040].
وعمرو بن ثابت، فيه كلام كثير، وقد حقّقنا الحال فيه وتبيّن أنّه صدوق حسن الحديث، وغاية ما أُخذ عليه إنّما هي أُمور خارجة عن محلّ التوثيق كالتشيّع والرفض وغيرها؛ لذا قال فيه ابن داوُد أنّه صدوقاً في الحديث، وليس في حديثه نكارة، بل لا يشبه حديثه أحاديث الشيعة[1041].
والأعمش ثقة جليل القدر، وغاية ما أُخذ عليه أنّه مُدلّس.
غير أنّ جلالة قدر الأعمش وكونه من أئمّة الحديث، جعلت الكثير من العلماء يغضّون الطرف عن الروايات التي عنعن فيها، ويحملونها على الاتّصال ما لم يتبيّن فيها الانقطاع؛ لذا قال الحافظ الفسوي: «وحديث سفيان، وأبي إسحاق، والأعمش، ما لم يُعلم أنّه مُدلّس يقوم مقام الحجّة»[1042].
ويظهر أنّ الإمام أحمد يرى الاحتجاج برواية الأعمش المعنعنة، قال أبو داوُد: «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يُعرف بالتدليس، يحتجّ فيما لم يقل حدّثني أو سمعت؟ قال: لا أدري. فقلت: الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال: يضيق هذا، أي: أنّك تحتجّ به»[1043].
بل إنّ رواياته في الصحيحين وهي معنعنة.
لذا فإنّ العلائي، وابن حجر ذكروه في الطبقة الثانية من طبقات الُمدلّسين، وهم: مَن احتمل الأئمّة حديثهم، وأخرجوا لهم في الصحيح؛ لإمامتهم وقلّة تدليسهم في جنب ما رووا[1044]، وهؤلاء يُقبل حديثهم سواء صرّحوا بالسماع أَم لم يصرّحوا.
والنتيجة: إنّ الكثير من العلماء يأخذون برواية الأعمش المعنعنة، ما لم يتبيّن لهم الانقطاع فيه، قال الألباني: «لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة، ما لم يظهر الانقطاع فيها»[1045].
كما أنّ البعض قصر تدليس الأعمش فيما إذا روى عن الصحابة دون غيرهم، منهم الشيخ شعيب الأرنؤوط، والدكتور بشّار عوّاد[1046].
وشقيق بن سلمة، أبو وائل، من رجال الستّة، ثقة مخضرم، بل قال ابنُ عبد البرّ: «أجمعوا على أنّه ثقة»[1047].
وبهذا يتّضح أنّ هذا السند معتبر لا غبار عليه، فالرواية حسنة الإسناد، ولو فرضنا أنّ فيه ضعفاً، فإنّ له طرقاً أُخرى يتقوّى بها كما يأتي.
2 ـ رواية عمر بن أبي سلمة عن أُمّ سلمة
أخرجها الشجري، قال: «أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان، قال حدّثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، قال: حدّثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدّثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، قال سمعت عبد الرحيم بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، يذكر عن أبيه، عن جدّه، عن أُمّ سلمة (رضي الله عنها)، قالت: جاء جبريل× إلى النبي’، فدخل عليه الحسن والحسين÷، فقال: إنّ أُمّتك تقتله ـ يعني الحسين× ـ بعدك، ثمّ قال: أَلا أُريك من تربة مقتله؟ قالت: فجاءه بحصيات فجعلهنّ رسول الله’ في قارورة، فلمّا كان ليلة قتل الحسين×، قالت أُمّ سلمة: سمعت قائلاً يقول:
|
أيّها القاتلون جهلاً
حسيناً |
|
أبشـروا بالعذاب
والتنكيل |
|
قد لُعنتم على لسان
ابن داوُد |
|
وموسى وصاحب الإنجيل |
قالت: فبكيت، قالت: ففتحت القارورة، فإذا قد حدث فيها دم»[1048].
وأخرجه الخوارزمي من طريق أبي طاهر محمد بن أحمد بالسند المتقدّم[1049].
وأورده الزرندي الحنفي عن أُمّ سلمة، وجاء في آخره: «فبكيت، وفتحت القارورة، فإذا الحصيات قد جرت دماً»[1050].
أمّا أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحيم، فهو إمام محدّث ثقة[1051].
وأمّا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان، فهو المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني، حافظ ثقة ثبت معروف[1052].
وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، هو الحافظ البزار صاحب المسند، قال فيه الخطيب: «وكان ثقة حافظاً، صنّف المسند، وتكلّم على الأحاديث، وبيّن عللها»[1053].
وقال الذهبي: «الحافظ العلّامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري، صاحب المسند الكبير المعلل»[1054].
إبراهيم بن سعيد الجوهري، من رجال مسلم والأربعة، ثقة حافظ[1055]، ومحمد بن جعفر بن محمد، الظاهر أنّه ثقة؛ لأنّ البخاري ذكره في تاريخه، وقال: «قال لي إبراهيم بن المنذر: كان إسحاق أخوه أوثق منه، وأقدم سنّاً»[1056]. وهذا القول يدلّ على أنّ الرجل ثقة أيضاً.
وذكره ابن أبي حاتم برواية جماعة عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، فقال: «روى عن أبيه، روى عنه عتيق بن يعقوب الزبيري، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، ويعقوب بن حميد بن كاسب، وأحمد بن محمد بن الوليد بن برد الأنطاكي، ومحمد بن أبي عمر العدني»[1057].
فبقرينة ذكر البخاري، وابن أبي حاتم له من دون جرح، ورواية عدّة من العدول عنه، والمفاضلة بينه وبين أخيه، بأنّ أخاه أوثق منه، يكون الرجل ثقة أو لا أقلّ من كونه صدوقاً حسن الحديث.
وأمّا عبد الرحيم بن محمد بن عمر بن أبي سلمة، فالظاهر هو عبد الرحمن؛ لأنّ ابن محمد هو عبد الرحمن، وقد ورد ذكره بروايته عن أبيه محمد في عدّة من الروايات[1058].
كما أنّ الخوارزمي نقل الرواية أعلاه من طريق عبد الرحمن، وليس عبد الرحيم[1059].
وعبد الرحمن هذا ذكره البخاري، وابن أبي حاتم الرازي من دون جرح ولا توثيق[1060]. وقد ذكرنا سابقاً أنّ جملة من العلماء يرون أنّ ذلك أمارة التوثيق.
كما أنّ ابن حبّان ذكره في ثقاته[1061]، وأخرج له في صحيحه[1062].
فالرجل يمكن الاعتماد عليه، ولا أقل من كون حديثه حسناً.
ومحمد بن عمر بن أبي سلمة، ذكره البخاري من دون جرح ولا تعديل[1063].
وذكره الرازي، وقال: «سمعت أبي يقول: لا أعرفه»[1064].
وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «محمد بن عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد، يروى عن أبيه، وله صحبة، روى عنه ابنه أبو بكر بن محمد»[1065].
وقول ابن حبّان: وله صحبة، الظاهر أنّه يرجع على أبيه عمر بن أبي سلمة؛ لأنّ عمر صحابي صغير، فلا يعقل أنْ يكون ابنه محمد صحابي أيضاً.
والخلاصة: إنّه مع سكوت البخاري عنه، وذكر ابن حبّان له في الثقات، وعدم وجود جرح فيه، يمكن الاعتماد عليه.
أمّا عمر بن أبي سلمة فهو صحابي[1066] كما أسلفنا فيكون ثقةً عدلاً.
وأُمّ سلمة، هي أُمّ المؤمنين زوج النبي’، صحابية.
وبهذا يتّضح أنّ هذالحديث جيد الإسناد، وهو متعاضد مع غيره من الأحاديث.
3 ـ رواية عبد المطلب بن حنتب عن أُمّ سلمة
أخرجها ابن العديم، قال: «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان الأسدي، قال: أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الكشميهني.
وأخبرنا علي بن عبد المنعم بن علي بن الحداد، قال: أخبرنا يوسف بن آدم المراغي، قالا: أنبأنا أبو بكر محمد بن منصور بن محمد السمعاني، قال: أخبرنا الشيخ أبو غالب محمد بن الحسن، قال: أخبرنا أبو علي بن شاذان، قال: أخبرنا عبد الخالق بن الحسن السقفي، قال: حدّثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال: حدّثنا يحيى الحماني، قال: حدّثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن حنطب، عن أُمّ سلمة، قالت: دخل علي النبي’، فقال لي: احفظي الباب لا يدخل عليّ أحد. فسمعت نحيبه، فدخلت، فإذا الحسين بين يديه، فقلت: والله يا رسول الله، ما رأيته حين دخل. فقال: إنّ جبريل كان عندي آنفاً، فقال لي: يا محمد أتُحبّه؟ فقلت: يا جبريل، أمّا مِن حبّ الدنيا، فنعم. قال: فإنّ أُمّتك ستقتله بعدك، تريد أُريك تربته يا محمد؟ فدفع إليّ هذا التراب. قالت أُمّ سلمة: فأخذته، فجعلته في قارورة، فأصبته يوم قُتل الحسين وقد صار دماً»[1067].
وأوردها ابن الأثير مختصراً، قال: «ورُوي أنّ النبي (صلّى الله عليه وسلّم) أعطي أُمّ سلمة تراباً من تربة الحسين، حمله إليه جبريل، فقال النبي (صلّى الله عليه وسلّم) لأُمّ سلمة: إذا صار هذا التراب دماً، فقد قُتل الحسين. فحفظت أُمّ سلمة ذلك التراب في قارورة عندها، فلمّا قُتل الحسين صار التراب دماً...»[1068].
أمّا عبد الرحمن فهو ثقة، قال فيه الذهبي: «وكان له فهم ومعرفة، وعناية تامّة بالحديث، وفيه دين وصلاح، ومعرفة بفقه الشافعي»[1069].
والكشهميني مجهول، لكن جهالته منجبره بورد الحديث من طريق آخر كما تقدّم، فإنّ ابن العديم رواه من وجهين ينتهيان إلى السمعاني.
والسمعاني، أبو بكر محمد بن منصور بن محمد، هو والد السمعاني صاحب الأنساب، حافظ ثقة معروف[1070].
والشيخ أبو غالب محمد بن الحسن الباقلاني، ذكره ابن نقطة، وقال: «ثقة»[1071].
وأبو علي بن شاذان، ترجمه الخطيب، وقال: «كتبنا عنه وكان صدوقاً صحيح الكتاب، وكان يفهم الكلام على مذهب الأشعري... وكتب عنه جماعة من شيوخنا كأبي بكر البرقاني، ومحمد بن طلحة النعالي، وأبي محمد الخلال، وأبي القاسم الأزهري، وعبد العزيز الأزجي، وغيرهم. سمعت أبا الحسن بن رزقويه يقول: أبو علي بن شاذان ثقة. وسمعت الأزهري يقول: أبو علي بن شاذان من أوثق مَن برّأ الله في الحديث»[1072].
وعبد الخالق بن الحسن السقفي، وثّقه البرقاني، والخطيب البغدادي[1073].
وإسحاق بن الحسن الحربي، ثقة حجّة[1074].
أمّا يحيى الحماني، فقد اضطربت فيه كلمات العلماء بين موثّق ومضعّف، بل تعدّدت فيه كلمات أحمد بن حنبل بين التوثيق والتضعيف.
وقد وثّقه جملة من العلماء، منهم: ابن نمير، والبوشنجي، والرمادي، وابن معين، وغيرهم، وضعفه النسائي، وابن المديني، وغيرهم[1075]، ولعلّنا من خلال كلام ابن معين، وابن عدي نستطيع أنْ نصل إلى نتيجة أنّ الرجل صدوقاً، حسن الحديث، خصوصاً أنّه من رجال مسلم، وقد أصرّ ابن معين على توثيقه، فقال فيه: «ابن الحماني، صدوق مشهور، ما بالكوفة مثل ابن الحماني، ما يقال فيه إلّا من حسد»[1076].
فابن معين على اطلاع تام بالرجل، وما قيل فيه، إلّا أنّه يرى أنّ ذلك بسبب الحسد، وكلّ كلماته تدل على أنّه متيقّن من وثاقة الرجل، فعن أحمد بن زهير، قال: «سمعت يحيى بن معين، يقول: يحيى بن عبد الحميد الحماني ثقة، وما كان بالكوفة في أيامه رجل يحفظ معه، هؤلاء يحسدونه»[1077].
وعن أبي جعفر، محمد بن عثمان بن أبي شيبة، قال: «سألت يحيى بن معين، عن يحيى بن عبد الحميد فقال: ثقة»[1078].
وعن عباس بن محمد الدوري، قال: «سمعت يحيى يقول: أبو يحيى الحماني، وابنه ثقة. قال عباس: ناظرناه في هذا غير مرّة»[1079].
وفي رواية أخرى عن الدوري، أنّه قال: «سمعت يحيى بن معين يقول: أبو يحيى الحماني ثقة، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ثقة. قال عباس: لم يزل يحيى يقول هذا حتى مات»[1080].
وعن صالح بن محمد، قال: «سمعت يحيى بن معين ـ وسُئل عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ـ فقال: «صاحب حديث صدوق»[1081].
وعن عبد الخالق بن منصور، قال: «سُئل يحيى بن معين، عن يحيى بن الحماني، فقال: صدوق ثقة»[1082].
وعن عبد الله بن محمد بن منيع، قال: «كنّا على باب يحيى بن عبد الحميد الحماني، فجاء يحيى بن معين على بغلته فسأله أصحاب الحديث ـ يعني أن يُحدّثهم ـ فأبى، وقال: جئت مُسلّماً على أبي زكريا، فدخل ثمّ خرج، فسألوه عنه. فقال: ثقة ابن ثقة»[1083].
وعن أبي هارون الهمداني قال: «سألت يحيى بن معين عن الحماني، فقال: ثقة. فقلت: يعنى يقولون فيه. فقال: يحسدونه، هو والله الذي لا إله إلّا هو ثقة»[1084].
فهذه الكلمات بيّنة وظاهرة في أنّ ابن معين يعرف الحماني جيّداً، ويعرف أنّ بعض العلماء يضعّفه، لكنّه مصر على أنّ الرجل ثقة.
وقال فيه ابن عدي، بعد أنْ ذكر الأقوال المختلفة فيه: «ولم أرَ في مسنده، وأحاديثه، أحاديث مناكير فأذكرها، وأرجو أنّه لا بأس به»[1085].
والظاهر أنّ منشأ تضعيفه يتعلّق بالعقيدة، فقد اتُّهم بالتشيّع، والطعن في معاوية، وفي هذا يقول العالم السنّي المعاصر حسن السقّاف: «وقد حمل عليه بعضهم لتشيّعه المحمود، ولطعنه في معاوية بن أبي سفيان، وقوله عنه: إنّه مات على غير ملة الإسلام، ومع ذلك وصفه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء بقوله: الحافظ الإمام الكبير، أبو زكريا ابن المحدّث الثقة أبى يحيى الحماني الكوفي، صاحب المسند الكبير. فتضعيفهم لا قيمة له البتة؛ لأنّه قد تبيّن سببه»[1086].
والمُحقَق علمياً أنّ العقيدة غير مؤثرة في التوثيق والتضعيف.
والخلاصة: إنّه مع التصريح بوثاقة الرجل، ومع التصريح من ابن معين بأنّ تضعيفهم له بسبب الحسد، ومع كون الرجل متّهم بالتشيّع، وأنّه يطعن في معاوية، لا يمكن التمسّك بالتضعيفات، كما أنّه لا يمكن طرحها بالكامل، فالجمع بين الأمرين يقتضي أنّ الرجل صدوقاً حسن الحديث.
وأمّا سليمان بن بلال فثقة، وثّقه أحمد، وابن معين، وابن سعد، وغيرهم[1087].
وعمرو بن أبي عمرو، قال فيه ابن حجر: «ثقة ربما وهم»[1088]. وقال الذهبي: «صدوق»[1089].
والمطلب بن حنطب، قال عنه الذهبي: «أحد الثقات»[1090].
وقال ابن حجر: «صدوق، كثير التدليس والإرسال»[1091]. لكن تعقبه محررا التقريب بشّار عوّاد وشعيب الأرنؤوط، فقالا: «بل ثقة، وروايته عن الصحابة منقطعة (مرسلة) إلّا سهل بن سعد، وأنساً، وسلمة بن الأكوع، ومَن كان قريباً منهم، ولم يتهمه أحد بالتدليس، لكن يظهر أنّهم يريدون بالتدليس الإرسال، وقد وثّقه أبو زرعة الرازي، ويعقوب بن سفيان، والدارقطني، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقد ضعّفه ابن سعد؛ بسبب كثرة إرساله»[1092].
وأُمّ سلمة، صحابية.
فالسند معتبر إلى أُمّ سلمة، والمطلب بن حنطب وإنْ كان عامّة ما يرويه منقطع عن الصحابة، إلّا أنّه من الممكن ملاقاته لأُمّ سلمة، فهو حي لسنة (120هـ)[1093]، وهذا يعني لو فرضنا أنّ عمره ناهز الثمانين، سيكون عاش عشرين سنة في حياة أُمّ سلمة.
اتّضح أنّه يمكن عدّ هذا السند من الأسانيد الجيّدة المعتبرة.
أوردها الخوارزمي، قال: قال شرحبيل بن أبي عون: «... ثمّ أخذ النبي’ تلك القبضة التي أتاه بها المَلَك، فجعل يشمّها ويبكي، ويقول في بكائه: اللهمّ لا تبارك في قاتل ولدي، وأصله نار جهنّم، ثمّ دفع تلك القبضة إلى أُمّ سلمة، وأخبرها بقتل الحسين بشاطئ الفرات، وقال: يا أُمّ سلمة، خذي هذه التربة إليك، فإنّها إذا تغيّرت وتحوّلت دماً عبيطاً، فعند ذلك يُقتل ولدي الحسين»[1094].
وهذه الرواية مرسلة لم نقف لها على سند، فهي ضعيفة من هذه الجهة.
5 ـ مرسلة عن سلمى المدنية عن أُمّ سلمة
أوردها الخوازمي في مقتله، قال: وجاء في المراسيل أنّ سلمى المدنيّة، قالت: «رفع رسول الله’ إلى أُمّ سلمة قارورة فيها رمل من الطفّ، وقال لها: إذا تحوّل هذا دماً عبيطاً، فعند ذلك يُقتل الحسين. قالت سلمى: فارتفعت واعية من حجرة أُمّ سلمة، فكنت أوّل مَن أتاها، فقلت لها: ما دهاك يا أُمّ المؤمنين؟ قالت: رأيت رسول الله في المنام، والتراب على رأسه، فقلت: مالك؟ قال: وثب الناس على ابني فقتلوه، وقد شهدته قتيلاً الساعة. فاقشعرّ جلدي وانتبهت وقمت إلى القارورة، فوجدتها تفور دماً. قالت سلمى: ورأيتها موضوعة بين يديها»[1095].
والرواية مرسلة، ومحكومة بالضعف كما هو واضح.
غير أنّ الرواية عن سلمى، عن أُمّ سلمة وردت مسندة بصورة مختصرة في مصادر عدّة، فقد أخرجها الترمذي، قال: «حدّثنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا أبو خالد الأحمر، أخبرنا رزين، قال حدّثتني سلمى، قالت: دخلت على أُمّ سلمة وهي تبكى، فقلت: ما يُبكيك؟ قالت: رأيت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ـ تعنى في المنام ـ وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت: مالك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفاً»[1096].
وأخرجها الطبراني[1097]، والآجري[1098]، وغيرهم.
وهذه الرواية تبيّن أنّ منشأ معرفة وعلم أُمّ سلمة بمقتل الحسين×، إنّما هي الرؤية التي رأتها للرسول الكريم’، وعلى رأسه ولحيته التراب، وأخبرها بأنّه شهد قتل الحسين× آنفاً، ولم تكمل أنّ أُمّ سلمة قامت وذهبت إلى القارورة التي أودعها النبي’ عندها، ورأت القارورة قد تحوّلت دماً.
ويبدو أنّ ذلك من فعل الرواة، فكثيراً ما يحصل أنّ بعض الرواة ينقلون القصة كاملة، وبعضهم يقتصرون على قسم منها، ولعلّ الرواية المرسلة المتقدّمة ترجّح أنّ المسندة اقتصرت على جزء من القصّة، خصوصاً أنّ مسألة المنام وذهاب أُمّ سلمة بعده إلى القارورة، قد ورد في كتب الفريقين كما أوضحنا.
وكيف ما كان، فإنّ هذه الرواية أيضاً محكومة بالضعف؛ وذلك لأنّ سلمى لم نقف على حالها، فهي مجهولة، واسمها «سلمى البكرية، من بكر بن وائل، مولاة لهم، روت عن عائشة، وأُمّ سلمة. وعنها رزين الجهني، ويقال البكري»[1099].
خلاصة الحكم على روايات أُمّ سلمة عند أهل السنّة
اتّضح أنّ الطرق الثلاثة المسندة التي ذكرناها كلّها حسنة الإسناد ومتعاضدة مع بعضها، واشتركت في المضمون المشار إليه، وهو تحوّل التربة إلى دم، فالحديث بمجموع طرقه يكون صحيحاً لغيره، ومع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من كونه حسناً لغيره.
ومضافاً للطرق الثلاثة المسندة، فقد أوردنا روايتين مرسلتين لم نقف على إسنادهما تتضامن وتؤيّد الطرق الثلاثة.
خلاصة الحكم على حادثة تحوّل التربة إلى دم
تبيّن أنّ هذه الحادثة وردت بطرق متعدّدة في كتب الفريقين، فقد وردت عند الشيعة من طريق أُمّ سلمة، وأنس بن مالك، ووردت عند السنّة من عدّة طرق عن أُمّ سلمة، فيمكن القول إنّ الحادثة ثابتة؛ لورودها في كتب الفريقين أوّلاً، ولتعدّد طرقها ثانياً، ولجودة بعض طرقها عند الشيعة، بل وجودة عدّة من طرقها وفق منهج أهل السنّة ثالثاً، وقد ذكرنا سابقاً أنّ نقل الرواية ـ خصوصاً مع جودة الإسناد ـ عند الفرقة الأُخرى مع ملاحظة اختلاف الأهواء والميولات والعقائد، يُشكّل قرينة قوية على صحّتها، فكيف مع اتّفاق الفريقين على النقل وبطرق متعدّدة.
شبهة: الحديث ضعيف؛ لأنّ أُمّ سلمة توفّيت قبل مقتل الحسين×
قد يقول قائل: بأنّ أُمّ سلمة توفّيت قبل مقتل الحسين×، فلا يمكن صدور تلك الروايات عنها، فتكون كلّها ضعيفة لا يمكن التمسّك بها.
ما ذُكر غير صحيح، فإنّه من غير المقطوع به أنّ وفاة أُمّ سلمة قبل مقتل الحسين×، حتّى نضعّف تلك الروايات على ضوئه، فقد اختلف في سنة وفاتها، فقيل: في سنة (59هـ). وقيل: سنة (60هـ)[1100]. وقيل: سنة (61هـ) [1101]. والظاهر أنّ الأخير هو الصحيح، وأنّها توفّيت بعد مقتل الحسين×؛ لدلالة الأخبار المتقدّمة على ذلك، ولوجود أخبار أُخرى تؤيّد بقاءها بعد مقتل الحسين×، فقد ورد عن شهر بن حوشب، أنّه قال: «أتيتُ أُمّ سلمة أُعزّيها بقتل الحسين بن علي»[1102].
والسند معتبر متعاضد ورد بحسب ما وقفنا عليه من طريقين عن شهر، وكلّ طريق متأرجح بين الحسن لذاته أو الضعيف ضعفاً خفيفاً، يرتفع عند المعاضدة لدرجة الحسن على ما عليه التحقيق.
وأخرج أحمد، والطبراني عن عبد الحميد بن بهرام، قال: «حدّثني شهر بن حوشب، قال: سمعت أُمّ سلمة زوج النبي (صلّى الله عليه وسلّم) حين جاء نعى الحسين بن علي، لعنت أهل العراق...»[1103].
فالسند جيد إلى شهر، وشهر وإنْ اختُلف فيه إلّا أنّ التوثيقات فيه قوية جدّاً، وحديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن على التحقيق؛ ولذا ذكره الذهبي في كتابه: (ذكر مَن تُكلّم فيه وهو مُوثّق أو صالح الحديث)، وذكر محقق الكتاب عبد الله الرحيلي: «أنّ الرجل مختلف فيه، والعمل على تحسين حديثه عند علماء الحديث»[1104].
وقال الشيخ حمزة أحمد الزين معلّقاً على الحديث: «إسناده حسن»[1105].
والغرض أنّ هذه شواهد على أنّ وفاة أُمّ سلمة بعد مقتل الحسين×، أي: في سنة (61هـ)، واختار هذا الرأي الذهبي، وقال: «وبعضهم أرّخ موتها في سنة تسع وخمسين، فوهم أيضاً، والظاهر وفاتها في سنة إحدى وستين (رضي الله عنها)»[1106].
وذهب ابن عساكر إلى هذا الرأي أيضاً، فقد روى أنّ أُمّ سلمة زوج النبي’ ماتت سنة إحدى وستين، حين جاء نعي الحسين، وقال بعد ذلك: «وهذا هو الصحيح»[1107].
ومن المعلوم أنّ الحسين قد استُشهد في اليوم العاشر من الشهر الأوّل ـ وهو شهر محرّم الحرام ـ من سنة (61هـ).
شبهة: روايات تحوّل التربة إلى دم تتنافى مع مطر السماء دماً
قد يتبادر إلى الذهن أنّ احمرار التربة يتنافى مع روايات مطر السماء دماً؛ لأنّ أُمّ سلمة كانت علامتها الوحيدة التي رأتها وصرخت على ضوئها هي احمرار التربة، وحين اجتمع عليها الناس من كلّ حدب وصوب، كانوا مستغربين، ولم يروا مطراً للسماء ولا غيره، فأخبرتهم أُمّ سلمة بما جرى، فإمّا أنْ تكون هذه الرواية لا صحة لها وتبقى روايات المطر سالمة، أو تكون هذه الحادثة ثابتة وروايات المطر غير ثابتة.
ويمكن أن يجاب عن ذلك بأُمور:
الأوّل: إنّ المطر لم يكن قد حصل في المدينة؛ بل حصل في مناطق أُخرى من العالم، فلا تنافي حينئذٍ، فعلامة أُمّ سلمة وهي احمرار التربة لا تتنافى مع غيرها، وفزع الناس واستغرابهم ممّا جرى يكون أمراً طبيعياً.
لكن مطر السماء في أنحاء أُخرى من العالم وعدم مطرها في مركز بيت الوحي بعيد جدّاً، فالمدينة كانت تمثّل ثقل العالم الإسلامي، وهي مركز الرسالة، وفيها بقيّة أهل البيت، فإنْ كان هناك من مطر فلا بدّ أنْ يكون شاملاً للمدينة، وقد رجّحنا سابقاً أنّ المطر شمل العالم الإسلامي بأسره.
الثاني: أنْ يكون الأمران قد حصلا في المدينة، لكن بعد فوارق زمنية قريبة، فمثلاً: حين رأت أُمّ سلمة احمرار التربة لم تكن السماء قد مطرت، وبعدها بوقت قصير، وبعد أن عرف الناس ماذا جرى احمرّت السماء ومطرت وحدث ما حدث.
الثالث: من المحتمل أنْ تكون الأُمور تزامنت فالجو اضطرب ونزلت الأمطار المحمّلة بالغبار، ولم يلتفت الناس إلى أنّ هذا دماً، وصاحبه صراخ أُمّ سلمة، فأقبلوا ليعرفوا الأمر، فأخبرتهم بما شاهدته عن التربة.
رواية ابن عباس في تحوّل بعر الظباء دماً وتنافيها مع رواية أُم سلمة
رأينا من المناسب أنْ نذكر هذا الخبر هنا؛ لتناسبه في المقام، ولتعارضه مع رواية أُمّ سلمة المروية عن ابن عباس كما سيتّضح.
والخبر في الحقيقة يتناول حادثة كونية أُخرى غير تحوّل التربة إلى دم عبيط، وهي سيلان الدم من بعر الظبا الذي احتفظ به ابن عباس، حينما كان في مسيره مع علي بن أبي طالب×.
وهذا الخبر تقدّم ذكره سابقاً في مسألة انكساف الشمس، وعرفنا أنّه قد روته المصادر الشيعية، نقلاً عن المصادر السنيّة، ولا نرى مبرراً لاعادة تخريجه، ونقتصر هنا على نقل ما يتعلّق بموضع الشاهد للضرورة إليه، فقد رُوى في الخرائج عن ابن مردويه، أنّ الإمام علي حين مرّ بكربلاء بكى بكاءً طويلاً وبيّن لابن عباس أنّ الإمام الحسين× سيُقتل هنا، وأنّ في هذا المكان بعر الظباء، وهي مصفرة لونها لون الزعفران، فأمر ابن عباس أنْ يطلبها، فوجدها ابن عباس كما وصفها الإمام، فأخذها الإمام وشمّها، وهو يقول: «هي هي بعينها، أتعلم يا بن عباس ما هذه الأباعر؟ [هذه] قد شمها عيسى بن مريم، وقال: هذا الطيب لمكان حشيشها». ثمّ إنّ الإمام أخذ من البعر وصرّه في ردائه، وأمر ابن عباس كذلك، وقال له: «إذا رأيتها تنفجر دماً عبيطاً، فاعلم أنّ أبا عبد الله قد قُتل بها [ودفن]. قال ابن عباس: لقد كنت أحفظها، ولا أحلّها من طرف كمّي، فبينا أنا في البيت نائم، وقد خلا عشر المحرّم إذ انتبهت، فإذا تسيل دماً، فجلست وأنا باكٍ، فقلت: قُتل الحسين، وذلك عند الفجر، فرأيت المدينة كأنّها ضباب، ثمّ طلعت الشمس وكأنّها منكسفة، وكأنّ على الجدران دماً، فسمعت صوتاً يقول وأنا باكٍ:
|
اصبروا آل الرسول |
|
قُتل الفرخ البجول |
|
نزل الروح الأمين |
|
ببكاء وعويل |
ثمّ بكى وبكيت، ثمّ حدّثت الذين كانوا مع الحسين، فقالوا: لقد سمعنا ما سمعت ونحن في المعركة، فكنّا نرى أنّه الخضر×»[1108].
وهذا الخبر ضعيف لا يمكن التمسّك به لأُمور ثلاثة:
أوّلها: إنّ السند ضعيف على كلا المبنيين سواء الشيعي أو السنّي، ويكفي في ذلك جهالة وضعف بعض رجاله، فمثلاً: أحمد بن يحيى بن زكريا القطان مجهول عند الشيعة، ولم أقف له على ذكر عند أهل السنّة، وتميم بن بهلول مجهول عند الشيعة، وليس له ذكر عند أهل السنّة، وعلي بن عاصم ضعيف عند أهل السنة، وليس له ذكر عند الشيعة، والمذكور عند الشيعة مختلف الطبقة عن ذاك كما أوضح السيّد الخوئي[1109]، وهكذا بقيّة الرجال بين الجهالة والخلاف بين الفريقين، فلا يسلم السند على مبنى أيّ منهما، فالخبر بهذا السند ضعيف.
وثانيها: إنّ في الخبر ما يدلّ على ضعفه أيضاً، وهو أنّ ابن عباس كان أعمى، فكيف تمكّن من رؤية سيلان الدم، وانكساف الشمس وما إلى ذلك من الأُمور المذكورة في الرواية؟!
وثالثها: إنّها معارضة لخبر أُمّ سلمة الذي تقدّم نقله عن الأمالي، بأنّ أُمّ سلمة رأت تحوّل التربة دماً وصرخت وجاءها الناس، وكان ممّن جاء مستفسراً عن الوضع هو ابن عباس يقوده قائده، ممّا يدل على أنّ ابن عباس قد كان أعمى، وأنّه قد عرف الخبر من أُمّ سلمة، ولم يعلم به قبل ذلك، فكيف رأى بعر الظبا تسيل دماً، وعرف من خلالها أنّ الحسين× قد قُتل؟!
القرآن الكريم.
ـ أ ـ
إتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي، محمود بن عبد الفتاح النحال، إشراف ومراجعة وضبط وتدقيق: الفريق العلمي لمشـروع موسوعة جامع السنة، الناشر: دار الميمان للنشـر والتوزيع، ط1، 1429هـ/2008 م، الرياض ـ السعودية.
إتحاف النبيّل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل، أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المآربي، تحقيق: أبو إسحاق الدمياطي، الناشر: مكتبة الفرقان، عجمان، ط2.
الآحاد والمثاني، أبو بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني، تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، الناشر: دار الراية، الرياض، ط1، 1411هـ.
الاحتجاج، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر الخرسان، الناشر: دار النعمان، النجف الأشرف، طبعة عام 1386هـ.
الأخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري، الناشر: دار إحياء الكتب العربي، تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال، ط1، 1960هـ.
أربع مجالس للخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، الناشر: مخطوط نُشـر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع لموقع الشبكة الإسلامية.
الأربعون في أصول الدين، فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، تحقيق: د. أحمد حجازي السقّا، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط1، 1406هـ.
الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد العكبري البغدادي، تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لتحقيق التراث، الناشر: دار المفيد، بيروت، ط2، 1414هـ.
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الألباني، محمد ناصر الدين، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، ط2، 1405هـ/1985م.
الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد، المشهور بابن عبد البرّ، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ.
أُسد الغابة في معرفة الصحابة، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت.
الإشراف في منازل الأشراف، أبو بكر عبد الله بن محمّد الأُموي المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: د. نجم عبد الرحمن خلف، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض ـ السعودية، ط1، 1411هـ/1990م.
الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ.
أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة، تأليف: نخبة من العلماء، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية، ط1، 1421هـ.
أُصول علم الرجال، تقريرات بحث الشيخ مسلم الداوري، تأليف: محمد علي صالح المعلم، ط2، 1426هـ، الناشر: مؤسسة المحبّين للطباعة والنشر.
أضواء على ثورة الإمام الحسين×، السيد محمد محمد صادق الصدر، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، قم ـ إيران، ط3، 1430هـ.
إعلام الورى بأعلام الهدى، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط1، 1417هـ.
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي، تحقيق: محمّد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنّة المحمديّةـ القاهرة، ط2 ـ 1369هـ.
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى، علي بن هبة الله بن أبي نصر بن ماكولا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ.
الأمالي الخميسية (ترتيب الأمالي الخميسية)، يحيى (المرشد بالله) بن الحسين (الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني، رتّبها: القاضي محيي الدين محمد بن أحمد القرشي، تحقيق: محمّد حسن محمد حسن إسماعيل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1422 هـ/2001 م.
الأمالي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، الناشر: دار الثقافة للطباعة والنشـر والتوزيع، قم، ط1، 1414هـ.
الأمالي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد، تحقيق: الحسين أستاد ولي ـ علي أكبر الغفاري، الناشر: دار المفيد للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط2، 1414 هـ/1993م.
الأمالي، الشريف أبو القاسم علي بن الطاهر أبي أحمد الحسين المرتضى، تصحيح وتعليق: السيد محمد بدر الدين النعساني الحلبي، الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، ط1، 1325هـ/1907م.
الأمالي، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، الناشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، قم، ط1، 1417هـ.
أمل الآمل، محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، الناشر: مكتبة الأندلس ـ بغداد.
الإنباء في تاريخ الخلفاء، محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني، تحقيق: قاسم السامرائي، الناشر: دار الآفاق العربية، القاهرة، ط1، 1421هـ/2001م.
أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري، تحقيق: د. سهيل زكار، ود. رياض زركلي، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط1، 1417هـ/1996م.
الأنساب، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني، تقديم وتعليق: عبد الله البارودي، الناشر: دار الجنان، بيروت، ط1، 1408هـ.
ـ ب ـ
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر المجلسـي، الناشر: مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، ط2، 1403هـ/1983م.
البداية والنهاية، ابن كثير الدمشقي، أبو الفداء، إسماعيل بن عمر، تحقيق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1408هـ.
بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، حجازي محمّد شريف الحويني الأثري، الناشر: مكتبة التربية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي، ط1، 1410هـ.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية، محمد بن محمد بن مصطفى الخادمى الحنفي، الناشر: مطبعة الحلبي، طبع سنة: 1348هـ.
بستان العارفين، يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الريان للتراث.
بستان الواعظين ورياض السامعين، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي، تحقيق: أيمن البحيري، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ـ لبنان، ط2، 1419هـ/1998م.
بغية الطلب في تاريخ حلب، كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة المعروف بابن العديم، تحقيق: د. سهيل زكار، الناشر: دار الفكر، بيروت.
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية، لبنان.
بلاغات النساء، أبو الفضل بن أبي طاهرالمعروف بابن طيفور، منشورات مكتبة بصيرتي، قم ـ إيران.
البلدان، أحمد بن محمد الهمذاني (ابن الفقيه الهمذاني)، تحقيق: يوسف الهادي، الناشر: عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط1، 1416هـ/1996م.
بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، الهلالي، سليم بن عيد، الناشر: دار ابن الجوزي.
ـ ت ـ
تاريخ ابن معين برواية الدارمي، ابن معين، يحيى بن معين بن عون المري، تحقيق: د. أحمد محمّد نور سيف، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت.
تاريخ ابن معين برواية الدوري، يحيى بن معين بن عون المري، المعروف بابن معين، تحقيق: عبد الله أحمد حسن، الناشر: دار القلم، بيروت.
تاريخ أسماء الثقات، عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي، تحقيق: صبحي السامرائي، المطبعة: الدار السلفية، الكويت، ط1، 1404هـ.
تاريخ الإسلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمرى، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان، ط1، 1407هـ.
تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري، مراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء، الناشر: مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط4، 1403هـ/1983م.
تاريخ الخلفاء، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: مطبعة السعادة، مصـر، ط1، 1371هـ.
التاريخ الكبير، البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الناشر: المكتبة الإسلامية، ديار بكر ـ تركيا.
تاريخ الكوفة، السيد حسين بن السيد أحمد البراقي النجفي، تحقيق: ماجد أحمد العطية، استدراكات السيد محمد صادق آل بحر العلوم، الناشر: انتشارات المكتبة الحيدرية، النجف ـ العراق، ط، 1424هـ/1382ش.
تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ.
تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله، تحقيق: علي شيري، الناشر: دار الفكر، بيروت، طبعة عام 1415هـ.
تاريخ واسط، أبو الحسن أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب (بَحْشَل) الرزّاز الواسطي، تحقيق: كوركيس عواد، الناشر: عالم الكتب، بيروت ـ لبنان، ط1، 1406هـ.
تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة التبصرة، السيد شرف الدين علي الحسيني الأسترآبادي، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي#، الناشر: مدرسة الإمام المهدي#، الحوزة العلمية، قم المقدّسة، ط1، 1407هـ/1366ش.
التبصرة، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت597هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1406ه/1986م.
تحرير التقريب، شعيب الأرنؤوط، بشار عواد، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417هـ/1997م.
التحرير الطاووسي المستخرج من كتاب حل الإشكال للسيد أحمد بن موسى الطاووس، تأليف: الشيخ حسن بن زين الدين صاحب المعالم، تحقيق: فاضل الجواهري، الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشـي النجفي، قم المقدّسة، ط1، 1411هـ.
تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: أبو قتيبة نظر الفاريابي، الناشر: مكتبة الكوثر، الرياض، ط2، 1415هـ.
تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تصحيح: عبد الرحمن بن يحيي المعلمي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
التذكرة الحمدونية، محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي، المعروف بابن حمدون، تحقيق: إحسان عبّاس وبكر عبّاس الناشر: دار صادر للطباعة والنشر، ط1، 1996م.
تذكرة الخواص، أبو المظفر يوسف بن فرغلي، المشهور بسبط ابن الجوزي، الناشر: مكتبة نينوى الحديثة، طهران.
تذكرة الخواص، أبو المظفر يوسف بن فرغلي، المشهور بسبط ابن الجوزي، تحقيق: الدكتور عامر النجار، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1429هـ/2008م.
تذكرة الخواص، أبو المظفر يوسف بن فرغلي، المشهور بسبط ابن الجوزي، تحقيق: حسين تقي زادة، الناشر: مركز الطباعة والنشـر للمجمع العالمي لأهل البيت، ط2، 1433هـ.
التذكرة بأحوال الموتى وأُمور الآخرة، القرطبي الأنصاري، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الناشر: مكتبة دار المنهاج ـ الرياض، طبعة عام 1425هـ.
تذكرة الموضوعات، محمّد طاهر بن علي الفتني، إدارة الطباعة المنيريّة، ط1، 1343هـ.
ترجمة الإمام الحسين× من تاريخ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي، المعروف بابن عساكر، تحقيق: محمد باقر المحمودي، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ط2، 1414هـ.
ترجمة الإمام الحسين× من طبقات ابن سعد بن منيع، محمد بن سعد، تهذيب وتحقيق: السيد عبد العزيز الطباطبائي، الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط1، 1415هـ.
التعديل والتجريح لـمَن خرّج عنه البخاري في الجامع الصحيح، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي، دراسة وتحقيق: أحمد البزار، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مراكش.
تعليقة على منهج المقال، الوحيد البهبهاني، منشورة على القرص الكمبيوتري (مكتبة أهل البيت^).
تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم والصحابة والتابعين)، أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد خطيب، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا.
تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء، المعروف بابن كثير، تقديم: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، طبعة عام 1412هـ/1992م.
تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)، الحسين بن مسعود الشافعي البغوي، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت.
تفسير الثعلبي (الكشف والبيان)، أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق: أبو محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط1، 1422هـ/2002م.
تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، محمد بن جرير الطبري، ضبط وتوثيق وتخريج: صدقي جميل العطار، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، طبعة عام 1415هـ.
تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي الأنصاري، تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
تفسير القمي، علي بن إبراهيم، تصحيح وتعليق وتقديم: السيد طيب الموسوي الجزائري، الناشر: مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر، قم ـ إيران، ط3، 1404هـ.
التفسير الكبير، الرازي، محمد بن عمر بن حسين الشافعي الطبرستاني، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط1، 1421هـ.
تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1415هـ.
تكملة الإكمال (تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا)، محمّد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، المعروف بابن نقطة، تحقيق: د. عبد القيوم عبد ريب النبيّ، الناشر: جامعة أُمّ القرى، مكّة المكرمة، ط1، 1410هـ.
تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، الناشر: دار المدينة المنورة، 1384هـ.
تلخيص المتشابه في الرسم، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: سُكينة الشهابي، الناشر: طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط1، 1985م.
تمام المنّة، الألباني، محمد ناصر الدين، الناشر: دار الراية، الرياض، المكتبة الإسلامية، عمان ـ الأردن، ط2، 1409هـ.
تناقضات الألباني الواضحات فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات، السيد حسن بن علي السقاف، الناشر: دار الإمام النووي، عمّان ـ الأردن، ط3، 1412هـ/1992م.
تنقيح المقال في علم الرجال، محمد رضا المامقاني، الناشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط1، 1434هـ.
تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط1، 1404هـ.
تهذيب الكمال، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي، تحقيق وضبط وتعليق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة عام 1413هـ.
توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، شمس الدين محمّد بن عبد الله بن محمّد القيسـي الدمشقي، تحقيق: محمّد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1993م.
ـ ث ـ
الثاقب في المناقب، عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي، المعروف بابن حمزة، تحقيق: الأستاذ نبيل رضا علوان، الناشر: مؤسّسة أنصاريان، قم المقدّسة، ط2، 1412هـ.
الثقات، محمّد بن حبّان التميمي البستي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، المطبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ط1، 1393هـ/1973م.
ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تقديم: السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان، الناشر: منشورات الشريف الرضي، قم ـ إيران، ط2، 1368ش.
ـ ج ـ
جامع أحاديث الشيعة، حسين الطباطبائي البروجردي، المطبعة العلمية ـ قم، طبعة عام 1399هـ.
جامع التحصيل في أحكام المراسيل، خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت، ط2، 1407هـ.
جامع الرواة، محمد بن علي الأردبيلي الغروي، الناشر: مكتبة المحمدي.
جامع بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد الله بن محمد، الناشر، المعروف بابن عبد البرّ،: دار الكتب العلمية، طبعة عام 1398هـ.
الجامع في الرجال، آية الله الشيخ موسى العباسي الزنجاني، تحقيق: السيد محمّد الحسيني القزويني بمساعدة اللجنة العلمية، الناشر: مؤسسة ولي عصر للدراسات الإسلامية، ط1، 1436هـ.
الجرح والتعديل، أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1371 هـ/1952م.
جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة، محمّد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتبة الإسلامية، عمّان، ط1، 1413هـ.
جواهر المطالب في مناقب الإمام علي×، أبو البركات شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي، تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم، ط1، 1415هـ.
ـ ح ـ
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
حاشية ردّ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين الحسيني الدمشقي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1415هـ.
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمّد العطار الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية.
حقبة من التاريخ، عثمان بن محمّد الخميس، الناشر: دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية.
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد الله، المعروف بأبي نعيم الأصبهاني، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط4، 1405هـ.
ـ خ ـ
الخرائج والجرائح، قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام المهدي#، ط1، 1409هـ.
خاتمة مستدرك الوسائل، حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط1، 1416هـ.
الخصائص الكبرى (كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب)، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الكتاب العربي، 1320هـ.
خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، المعروف بالعلاّمة الحلّي، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة، ط1، 1417هـ.
الخلاصة في أُصول الحديث، الحسين بن عبد الله الطيبي، تحقيق: صبحي السامرائي، عالم الكتب، ط1، 1405هـ.
ـ د ـ
الدرر السنية في الأجوبة النجدية، تأليف: علماء نجد الأعلام، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط6، 1417هـ/1996م.
الدر المنثور في التفسير بالمأثور، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
الدر النظيم، الشيخ جمال الدين يوسف بن حاتم العاملي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ إيران.
دراسة في حديث السفينة على مباني أهل السنّة، د. حكمت جارح الرحمة، الناشر: مركز بين المللي، ترجمة ونشـر المصطفى، قم ـ إيران، ط1، 1394ش.
دروس معرفة الوقت والقبلة، حسن حسن زادة آملي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم ـ إيران، ط4، 1416هـ.
الدروع الواقية، علي بن موسى ابن طاووس، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط1، 1414هـ.
دلائل الإمامة، محمّد بن جرير بن رستم الطبري، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم، الناشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، قم ـ إيران، ط1، 1413هـ.
الدمعة الساكبة في أحوال النبيّ والعترة الطاهرة، المولى محمّد باقر بن عبد الكريم البهبهاني، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط1، 1408هـ.
ـ ذ ـ
ذخائر العقبى، أحمد بن عبد الله الطبري، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، طبعة عام 1356هـ.
الذرية الطاهرة الدولابي، محمد بن أحمد الرازي، تحقيق: سعد المبارك الحسن، الناشر: الدار السلفية، الكويت، ط1، 1407هـ.
ذكر أخبار أصبهان، أحمد بن عبد الله، المعروف بأبي نعيم الأصبهاني، الناشر: مطبعة بريل، ليدن، طبعة عام: 1934م.
ذكر أسماء مَن تُكلّم فيه وهو موثق، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: محمد شكور أمرير المياديني، الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء، ط1، 1406هـ.
ذيل تاريخ بغداد، الحافظ محب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن، المعروف بابن النجار البغدادي (ت643ه)، دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتاب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1417ه/1997م.
ـ ر ـ
ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، جار الله الزمخشـري (583ه)، الناشر: مؤسسة الأعلمي، بيروت ط1، 1412ه.
رجال الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، الناشر: جماعة المدرّسين، قم، ط1، 1415هـ.
رجال النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد النجاشي، الناشر: جماعة المدرّسين ـ قم، ط5، 1416هـ.
الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، المعروف ابن الجوزي، تحقيق: د. هيثم عبد السلام محمد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 2005م/1426هـ.
الرسائل الرجالية، أبو المعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي، تحقيق: محمد حسين الدرايتي، الناشر: دار الحديث للطباعة والنشـر، قم ـ ايران، ط1، 1422هـ/1380ش.
رسالة في إثبات كرامات الأنبياء، السجاعي، شهاب الدين أحمد بن أحمد، الناشر: مكتبة ايشيق، إستانبول، تركيا، سنة الطبع: 1396هـ/1976م.
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة، ابن قيم الجوزية، شمس الدين محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1395هـ/1975م.
روضة الطالبيين، النووي، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
روضة المتقين في شرح من لا يحضـره الفقيه، محمّد تقي المجلسـي الأوّل، علّق عليه وأشرف على طبعه: السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي، الناشر: بنياد فرهنك إسلامي حاج محمد حسين كوشانپور.
روضة الواعظين، محمّد بن الفتال النيسابوري، الناشر: منشورات الرضي قم ـ إيران.
رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين، يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، ط2، 1411هـ/1991م.
ـ ز ـ
زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد، المعروف ابن الجوزي، تحقيق: محمّد عبد الرحمن عبد الله، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، ط1، 1407هـ.
ـ س ـ
سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرة العباد، محمّد بن يوسف الصالحي الشامي، تحقيق: الشيخ عبد المعز عبد الحميد الجزار، الناشر: لجنة إحياء التراث الإسلامي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، مصر، 1416هـ/1995م.
سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمّد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، 1415هـ.
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، محمّد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط5، 1412هـ.
سنن أبي داود، أبو داود، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو السجستاني، تحقيق وتعليق: سعيد محمد اللحام، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط1، 1410هـ.
سنن الترمذي، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمّد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ.
سنن الترمذي، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق: أحمد محمّد شاكر، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
سنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني البغدادي، تعليق وتخريج: مجدي بن منصور سيد الشوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، طبع سنة 1417هـ.
السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: د. زياد محمّد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، 1414هـ.
سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني في الجرح والتعديل الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي، تحقيق: مجدي فتحي السيد، دار الصحابة للتراث، طنطا، ط1، 1413هـ.
سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي، تحقيق: د. موفق بن عبد الله بن عبدالقادر، مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1404هـ.
سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني البغدادي، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، ط1، 1404هـ.
سؤالات للعلّامة محدّث العصر الألباني، سألها له ابن أبي العينين، أحمد بن إبراهيم، الناشر: مهبط الوحي، 2002م.
سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، إشراف وتخريج: شعيب الأرنؤوط، تحقيق: حسين الأسد، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط9، 1413هـ.
السيرة النبويّة، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
ـ ش ـ
شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد، المعروف بابن العماد العكري الحنبلي، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرنؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق، ط1، 1406هـ.
شرح إحقاق الحق المرعشي، شهاب الدين المرعشـي النجفي، تحقيق: السيد إبراهيم الميانجي، الناشر: مكتبة المرعشي ـ قم.
شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار، أبو حنيفة بن محمد بن منصور المغربي، المعروف بالقاضي النعمان، تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي، الناشر: جماعة المدرّسين ـ قم، ط2، 1414هـ.
شرح الشفا للقاضي عياض، شرحه الملا علي القاري، ضبطه وصحّحه: عبد الله محمد الخليلي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1421هـ/2001م.
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، ط4، 1391هـ.
شرح العقيدة الواسطية، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، خرج أحاديثه واعتنى به: سعد بن فواز الصميل، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط6، 1421هـ.
شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، الناشر: دار الفكر، بيروت، ط2.
شرح مشكل الآثار، أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان، ط1، 1408هـ/1978م.
شرح نهج البلاغة، عزّ الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد، المعروف بابن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية.
الشريعة، أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط2، 1420هـ/1999م.
ـ ص ـ
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حمّاد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1407هـ.
صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبّان التميمي البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط2، 1414هـ.
صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي، ط2، 1412هـ/1999م.
صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح)، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، الناشر: دار الفكر، بيروت، طبعة عام 1401هـ.
صحيح الترغيب والترهيب، محمّد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، 1421هـ.
صحيح شرح العقيدة الطحاوية، السقاف، حسن بن علي، الناشر: دار الإمام النووي ـ الأردن، ط1، 1416هـ.
صحيح مسلم بشـرح النووي (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة عام 1407هـ.
الصراط المستقيم، علي بن يونس العاملي، الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، ط1، 1384هـ.
الصواعق المحرقة، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي، كامل محمد الخراط، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط1، 1417هـ.
ـ ض ـ
الضعفاء الصغير، محمّد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشـر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط1، 1406هـ/1986م.
ـ ط ـ
الطبقات الكبرى (الجزء المتمّم لطبقات ابن سعد) [الطبقة الخامسة في مَن قُبض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. وهم أحداث الأسنان]، أبو عبد الله محمّد بن سعد بن منيع البصـري البغدادي، المعروف بابن سعد، تحقيق: محمّد بن صامل السلمي، الناشر: مكتبة الصديق، الطائف، ط1، 1414هـ/1993م.
الطبقات الكبرى، (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم)، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصـري البغدادي، المعروف بابن سعد، تحقيق زياد محمد منصور، الناشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1408هـ.
الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصـري البغدادي، المعروف بابن سعد، الناشر: دار صادر، بيروت.
طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، المعروف بأبي الشيخ، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق البلوشي، الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ط2، 1412هـ.
طبقات المدلسين، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوني، مكتبة المنار، ط1.
طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، علي أصغر بن محمّد شفيع البروجردي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامّة، قم المقدسة، ط1، 1410هـ.
ـ ع ـ
العبر في خبر مَن غبر، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
العقد الفريد، ابن عبد ربّه الأندلسي، أحمد بن محمد، الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، ط3، 1420هـ.
العقد النضيد والدر الفريد في فضائل أمير المؤمنين وأهل بيت النبي^، محمّد بن الحسن القمّي، تحقيق: علي أوسط الناطقي، الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر، ط1، 1423هـ/1381ش.
العقيدة، رواية أبي بكر الخلال، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله، تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروان، الناشر: دار قتيبة، دمشق، ط1، 1408هـ.
علل الشرائع، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم، الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، طبعة عام 1385هـ.
علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)، عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح، تعليق وشرح وتخريج: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416هـ.
العمدة، شمس الدين يحيى بن الحسن الأسدي الحلّي، المعروف بابن البطريق، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، طبعة عام 1407هـ.
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، أبو بكر محمّد بن عبد الله، المعروف بابن العربي، تحقيق: محب الدين الخطيب، ومحمود مهدي الاإستانبولي، الناشر: دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط2، 1407هـ/1987م.
عيون أخبار الرضا، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تحقيق: حسين الأعلمي، الناشر: مؤسسة الأعلمي، بيروت، طبعة عام 1404هـ.
عيون الأخبار، أبو محمد عبد الله بن مسلم، المعروف بابن قتيبة الدينوري، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، نشر عام 1418هـ.
ـ غ ـ
غاية النهاية في طبقات القراء، شمس الدين محمّد بن محمّد بن علي ابن الجزري، تحقيق: ج. برجستراسر، الناشر:دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 2006م.
غريب الحديث، أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، الناشر: جامعة أُمّ القرى، مكّة المكرمة، طبع سنة 1402هـ.
غريب الحديث، إبراهيم بن إسحاق الحربي، تحقيق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة، ط1، 1405هـ.
غنية الملتمس إيضاح المشتبه، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تحقيق: د. يحيى بن عبد الله البكري الشهري، مكتبة الرشيد، الرياض، ط1، 1422هـ.
ـ ف ـ
الفتاوى الحديثية، أحمد بنه محمد بن حجر الهيتمي المكي، الناشر: دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.
فتاوى الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، جمعها: ابنه شمس الدين محمّد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، الناشر: المكتبة الإسلامية.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، حقوق الطبع محفوظة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، الناشر: دار المعرفة ـ بيروت، ط2.
فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1403هـ.
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم، حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: مكتبة دار البيان، دمشق، 1405هـ/1985م.
فضائل الصحابة، أبو عبد الله أحمد بن حنبل، تحقيق: د. وصي الله محمّد عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1403هـ.
فقه الحج (بحوث استدلالية في الحج)، الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني، الناشر: مؤسسة سيدة المعصومة، قم ـ إيران، ط1، 1423هـ/1381ش.
الفهرست، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب المعروف بابن النديم، تحقيق: رضا ـ تجدد.
الفهرست، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق: الشيخ جواد القيومي، الناشر: مؤسسة نشر الفقاهة، ط1، 1417هـ.
الفوائد الرجالية، السيد محمّد مهدي بحر العلوم، الناشر: مكتبة الصادق، طهران ـ إيران، ط1، 1363ش.
الفوائد المنتقاة الحسان الصحاح والغرائب، علي بن الحسن الخلعي، (مخطوط) من برنامج جوامع الكلم.
الفوائد، تمام بن محمد الرازي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1412هـ.
فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد عبد الرؤوف المناوي، تصحيح: أحمد عبد السلام، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ.
ـ ق ـ
قاموس الرجال، محمد تقي التستري، الناشر: مؤسسة النشـر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة، ط1، 1419هـ.
القاموس المحيط، محمّد بن يعقوب الفيروزآبادي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت.
قرب الإسناد، الحميري القمي، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، ط1، 1413هـ.
قصص الأنبياء، قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، تحقيق: الميرزا غلام رضا عرفانيان اليزدي الخراساني، الناشر: الهادي، قم ـ إيران، ط1، 1418هـ/1376ش.
قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: خليل محيي الدين، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ط1، 1405هـ/1985م.
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمّد جمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1399هـ.
قواعد في علوم الحديث، ظفر أحمد العثماني التهانوي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدّة، مكتب المطبوعات الإسلامية، الرياض، ط5، 1404هـ.
ـ ك ـ
الكاشف في معرفة مَن له رواية في الكتب الستّة، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: محمد عوامة، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية ـ جدّة، ط1، 1413هـ.
الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني البغدادي، تعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، ط5، 1363ش.
كامل الزيارات، جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي، تحقيق: جواد القيومي، الناشر: مؤسّسة نشر الفقاهة، ط1، 1417هـ. وطبعة أخرى بتحقيق: بهراد الجعفري، وإشراف: علي أكبر الغفّاري، نشر صدوق، 1375ش.
الكامل في التاريخ، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد، المعروف بابن الأثير الجزري، الناشر: دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشـر، بيروت ـ لبنان، طبعة عام 1385هـ/1966م.
الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمّد الجرجاني، قراءة وتدقيق: يحيى مختار غزاوي، دار الفكر، بيروت، ط3، 1409هـ.
كتاب السنّة (ابن أبي عاصم الضحاك، أبو بكر عمرو الشيباني) ومعه ظلال الجنة في تخريج السنّة، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي ـ بيروت، ط3، 1993م.
كتاب الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمّد بن عمرو المكي العقيلي، تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1418هـ.
كتاب الفتوح، أبو محمد أحمد بن محمد، المعروف بابن أعثم الكوفي، تحقيق: علي شيري، الناشر: دار الأضواء ـ لبنان، ط1، 1411هـ.
كرامات الأولياء (كرامات أولياء الله عزّ وجلّ)، هبة الله بن الحسن اللالكائي الطبري، تحقيق: د. أحمد سعد الحمان، الناشر: دار طيبة، الرياض، ط1، 1412هـ.
كشف الغمة في معرفة الأئمّة، أبو الحسن عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الإربلي، الناشر: دار الأضواء، بيروت ـ لبنان، ط2، 1405ه/1985م.
كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب×، محمد بن يوسف الكنجي الشافعي، تحقيق وتصحيح وتعليق: محمد هادي الأميني، الناشر: دار إحياء تراث أهل البيت^، ط3، 1404هـ.
الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق: أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405هـ.
كمال الدين وتمام النعمة، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم، طبعة عام 1405هـ.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي، ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني، تصحيح وفهرسة: الشيخ صفوة السقا، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة عام 1409هـ.
الكواكب النيرات، أبو البركات محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف، المعروف بابن الكيال الشافعي، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت ـ لبنان، ط2، 1407هـ/1987م.
ـ ل ـ
اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: أبو عبد الرحمن صلاح بن محمّد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ.
اللباب في تهذيب الأنساب، عز الدين علي بن محمّد، المعروف بابن الأثير الجزري، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، الناشر: دار صادر، بيروت ـ لبنان.
لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، المعروف بابن منظور، دار صادر، بيروت، ط1.
لسان الميزان، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت، ط2، 1390هـ/1971م.
اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى، المعروف بابن طاووس، الناشر: أنوار الهدى، قم ـ إيران، ط1، 1417هـ.
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي، الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتها ـ دمشق، ط2، 1402هـ/1982م.
ـ م ـ
مثير الأحزان، نجم الدين جعفر بن محمّد بن نما الحلي، الناشر: المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، سنة الطبع: 1369هـ/1950م.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1408هـ.
مجابو الدعوة، أبو بكر عبد الله بن محمّد، المعروف بابن أبي الدنيا.
مجالس ثعلب، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب.
المجروحين، محمّد بن حبّان التميمي البستي، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع، مكّة.
مجلة تراثنا، نشـرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، العدد الثاني، السنة الأُولى، خريف سنة 1406هـ، الناشر: مؤسسة آل لإحياء التراث، قم ـ إيران.
المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين النووي، الناشر: دار الفكر ـ بيروت.
المحاسن والمساوئ، إبراهيم بن محمّد البيهقي، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعارف، القاهرة.
المحاضرات والمحاورات، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1424هـ.
محدّث العصر الإمام الألباني كما عرفته، عصام موسى هادي، الناشر: دار الصديق، ط1، 1423هـ.
المحن، أبو العرب محمّد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي، تحقيق: د. عمر سليمان العقيلي، الناشر: دار العلوم، الرياض ـ السعودية، ط1، 1404هـ/1984م.
المختار من مناقب الأخيار، المبارك بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري، حقّقه وعلّق عليه: مأمون الصاغرجي، عدنان عبد ربه، محمد أديب الجادر.
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله بدر الدين البعليّ، تحقيق: عبد المجيد سليم ـ محمد حامد الفقي، الناشر: مطبعة السنة المحمدية.
مدينة معاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشـر: السيد هاشم بن سليمان البحراني. تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي الهمداني، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط1، 1413هـ.
مرآة الزمان في تواريخ الأعيان، سبط ابن الجوزي، تحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: الرسالة العالمية، ط1، 1434هـ/2013م.
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمد باقر المجلسـي، الناشر: دار الكتب الإسلامية، طهران ـ إيران، ط2، 1404هـ/1363ش.
المستدرك على الصحيحين، محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي، إشراف: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت.
مستدركات علم رجال الحديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي، الناشر: ابن المؤلف على نفقة حسينية عماد زاده، أصفهان، ط1، 1412هـ.
مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: دار الحديث، القاهرة، تعليق: حمزة أحمد الزين، وأحمد محمد شاكر، ط1، 1995م.
مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1416هـ.
مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله، أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: دار صادر ـ بيروت.
مسند البزار (البحر الزخار)، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم ـ بيروت، المدينة، ط1، 1409هـ.
مشايخ الثقات، الميرزا غلام رضا عرفانيان، الناشر: مؤسسة النشـر الإسلامي، ط1، 1417هـ.
المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق وتعليق: سعيد اللحام، دار الفكر للطباعة، بيروت، ط1، 1409هـ.
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، ط1، 1419هـ.
معارج الوصول إلى فضل آل الرسول، محمد بن يوسف الزرندي، تحقيق: ماجد بن أحمد بن عطية.
معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنّفين منهم قديماً وحديثاً، ابن شهر آشوب المازندراني. مطبعة فردين، طهران، 1353هـ.
معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين÷، الشيخ محمد مهدي الحائري، الناشر: موسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، ط1، 1432هـ.
معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب)، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي البغدادي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1411 هـ/1991م.
المعجم الأوسط، أبو القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين، الناشر: دار الحرمين، طبعة عام 1415هـ.
معجم البلدان، أبو عبد الله، ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة عام 1399هـ.
المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2.
المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، تحقيق: مجمع اللغة العربية، الناشر: دار الدعوة.
معجم رجال الحديث، أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي الخوئي، ط5، 1413هـ.
المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي، أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، تحقيق: د. زياد محمّد منصور، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، 1410هـ.
معرفة الثقات، أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط1، 1405هـ.
معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر، الرياض، ط1، 1419هـ/1998م.
المعرفة والتاريخ، يعقوب بن سفيان الفسوي، تحقيق: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 1419هـ/1999م.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمّد بن الخطيب الشربيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبع سنة 1377هـ/1958م.
مفتاح الفلاح في عمل اليوم والليلة من الواجبات والمستحبات والآداب، بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد البهائي الحارثي الهمداني، الناشر: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان.
مقاتل الطالبيين، أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، تحقيق: السيد أحمد صقر، الناشر: دار المعرفة، بيروت.
مقتل الحسين×، الموفق بن أحمد الخوارزمي، تحقيق: محمد السماوي، انتشارات أنوار الهدى، ط5، 1431هـ/2010م.
مقتل الحسين×، لوط بن يحيى، المعروف بأبي مخنف، تعليق: حسن الغفاري، المطبعة العلمية، قم.
مقتل الحسين×، لوط بن يحيى، المعروف بأبي مخنف، منشورات الشريف الرضي، قم ـ إيران، ط2.
مقدمة ابن أبي العينين على كتاب الضعفاء الصغير للبخاري (المطبوعة في أول الكتاب)، أحمد بن إبراهيم ابن أبي العينين، الناشر: مكتبة ابن عبّاس، ط1، 1426هـ.
مقدمة على كتاب المسح على الجوربين للقاسمي، أحمد محمّد شاكر، مطبوعة في أول الكتاب، تحقيق: محمّد ناصر الدين الإسلامي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1399هـ.
مقدمة فتح الباري (هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري)، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1408هـ.
الملاحم والفتن، علي بن موسى بن جعفر، المعروف بابن طاووس، الناشر: مؤسسة صاحب الأمر، تحقيق: مؤسسة صاحب الأمر#، ط1، 1416هـ.
مَن تكلّم فيه وهو موثوق أو صالح الحديث، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي، ط1، 1426هـ/2005م.
مَن لا يحضره الفقيه، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة، ط2.
مناقب آل أبي طالب، مشير الدين محمد بن علي، المعروف بابن شهر آشوب المازندراني، تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، الناشر: المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، طبعة عام 1376هـ.
مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب×، محمّد بن سليمان الكوفي، تحقيق: محمّد باقر المحمودي، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية،قم المقدّسة، ط1، 1412هـ. وكذلك: ط2، 1423هـ.
مناقب علي بن أبي طالب وما نزل من القرآن في عليّ، أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني، جمعه ورتّبه وقدم له: عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين، الناشر: دار الحديث، قم ـ إيران، ط2، 1424هـ/1382ش.
مناقب علي بن أبي طالب، علي بن محمّد الواسطي المعروف بابن المغازلي، الناشر: انتشارات سبط النبي|، ط1، 1426هـ/1384ش.
المنامات، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط1، 1413هـ.
المنتخب للطريحي في جمع المراثي والخطب المشتهر بـ الفخري، الشيخ فخر الدين الطريحي النجفي، الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط1، 1424هـ.
المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الناشر: مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان، طبع سنة: 1358هـ/ 1939م.
المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي، الناشر: دار صادر، بيروت، ط1، 1358هـ.
منتهى المقال في أحوال الرجال، أبو علي محمد بن اسماعيل الحائري المازندراني، تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط1، 1416هـ.
منهاج السنة النبويّة في نقض كلام الشيعة القدرية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم المشهور بابن تيمية، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: مؤسسة قرطبة، بيروت، ط1، 1406هـ.
المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبويّ ابن جماعة، محمّد بن إبراهيم، تحقيق: د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط2، 1406هـ.
المواقف، عبد الرحمن بن أحمد الأيجي، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، الناشر: دار الجيل، بيروت ـ لبنان، ط1، 1417هـ/1997م.
الموسوعة الفقهية الكويتية، صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الكويت، ط2، طبع الوزارة، 1408هـ.
موقع الآلوكة الإلكتروني من على الرابط التالي:
http://www.alukah.net/audio_books/11/15866.
ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ط1، 1963م.
ـ ن ـ
النبوات، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، الناشر: المطبعة السلفية ـ القاهرة، 1386هـ.
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري الأتابكي، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصـرية العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت852هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط3، 1421هـ.
نظم درر السمطين في فضائل المصطفى والمرتضى والبتول والسبطين، جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الحنفي، ط1، 1377هـ/1958م.
نقد الرجال، السيد مصطفى بن الحسين التفريشـي، تحقيق ونشـر: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط1، 1418هـ.
النكت البديعات على الموضوعات، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: د. عبد الله شعبان، دار مكة المكرمة، ط1، 1425هـ.
النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو عبد الله محمّد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق: د. زين العابدين بن محمّد بلا فريج، أضواء السلف، الرياض، ط1، 1419هـ.
النكت والعيون (تفسير الماوردي)، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
نهاية الإرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، تحقيق: مفيد قمحية وجماعة، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ط1، 1424هـ.
نوادر المعجزات، محمد بن جرير الطبري (الشيعي)، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي، الناشر: مؤسسة الإمام المهدي، قم ـ إيران، ط1، 1410هـ.
نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني، دار الجيل، بيروت، طبعة عام 1973م.
ـ هـ ـ
الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (رجال صحيح البخاري)، أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن البخاري الكلاباذي، تحقيق: عبد الله الليثي، الناشر: دار المعرفة، بيروت، ط1، 1407هـ.
الهواتف، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: مؤسّسة الكتب الثقافية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1413هـ.
ـ و ـ
الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث، بيروت، طبعة عام 1420هـ.
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، الناشر: دار الثقافة، بيروت.
وقائع عصر الأنغلو ساكسون، كتاب يتحدث عن التاريخ البريطاني، منشور من على الموقع الالكتروني:
http://www.britannia.com/history/docs/676-99.html.
وقعة صفين، نصـر بن مزاحم المنقري، الناشر: المؤسسة العربية الحديثة ـ القاهرة، ط2، 1382هـ ش.
ـ ي ـ
ينابيع المودّة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، تحقيق: سيد علي جمال أشرف الحسيني، الناشر: دار الأُسوة، ط1، 1416هـ.
[1] النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب: ج5، ص59.
[2] البعليّ، محمد بن علي، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية: ص600.
[3] ابن حنبل، أحمد، العقيدة (رواية أبي بكر الخلال): ص125ـ 126.
[4] اُنظر: ابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية: ص558.
[5] اُنظر: العطار الشافعي، حسن بن محمّد، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: ج2، ص481.
[6] ابن عابدين، محمد، حاشية ردّ المحتار على الدر المختار: ج1، ص465.
[7] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بشرح النووي: ج14، ص19.
[8] النووي، يحيى بن شرف، رياض الصالحين: ص587.
[9] القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القران(تفسير القرطبي): ج11، ص28.
[10] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج17، ص355.
[11] علماء نجد الأعلام، الدرر السنية في الأجوبة النجدية: ج1، ص32.
[12] نخبة من العلماء، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة: ص204.
[13] اُنظر: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، الأربعون في أصول الدين: ج2، ص199. الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف: ج3، ص464.
[14] اُنظر: الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف: ج3، ص464. لوامع الأنوار، السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي: ج2، ص394.
[15] اُنظر في ذلك: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، الأربعون في أُصول الدين: ج2، ص203 ـ 205.
[16] الأنفال: الآية34.
[17] يونس: الآية62ـ 64.
[18] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج7، ص190.
[19] العطار الشافعي، حسن بن محمّد، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: ج2، ص481.
[20] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج11، ص293.
[21] السقاف، حسن بن علي، صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ص616.
[22] العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، شرح العقيدة الواسطية: ج2، ص298.
[23] اُنظر: السفاريني الحنبلي، محمد بن أحمد، لوامع الأنوار البهية: ج2، ص392. واُنظر: السجاعي، أحمد بن أحمد، رسالة في إثبات كرامات الأنبياء: ص3.
[24] ابن عابدين، محمد، حاشية ردّ المختار: ج3، ص606.
[25] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم بشرح النووي: 16، ص108.
[26] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الحديثية: ص301 ـ 302.
[27] المصدر السابق: ص302 ـ 303.
[28] العطار الشافعي، حسن بن محمّد، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: ج2، ص474.
[29] وقد عُرِف عن المعتزلة إنكارهم للكرامة وذلك لالتباسها بالمعجزة وعدم إمكان التفريق بينهما فلا يتميّز بين النبيّ وغيره كما يدّعون.
[30] ابن عابدين، محمد، حاشية رد المختار: ج3، ص605.
[31] نخبة من العلماء، أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة: ص203.
[32] اُنظر: الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف: ج3، ص465. السجاعي، أحمد بن أحمد، رسالة في إثبات كرامات الأنبياء: ص3. الهلالي، سليم بن عيد، بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: ج2، ص594.
[33] الهلالي، سليم بن عيد، بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين: ج2، ص594 ـ 595.
[34] فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، الأربعون في أصول الدين: ج2، ص203.
[35] اُنظر: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، تفسير الرازي: ج21، ص76 ـ 77.
[36] النووي، يحيى بن شرف، بستان العارفين: ص59.
[37] اُنظر: العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، شرح العقيدة الواسطية: ج2، ص299. وذكر هذه الكرامة أو أشار إليها عدّة آخرين، فاُنظر: الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف: ج3، ص465. النووي، يحيى بن شرف، رياض الصالحين: ص587، فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، الأربعون في أصول الدين: ج2، ص203. ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الحديثية: ص301.
[38] اُنظر في ذلك: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، الأربعون في أصول الدين: ج2، ص202. الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف: ج3، ص465. النووي، يحيى بن شرف، رياض الصالحين: ص587. اللالكائي، هبة الله بن الحسن، كرامات الأولياء: ص70، ص74 ـ 77. ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الحديثية: ص301. العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، شرح العقيدة الواسطية: ج2، ص299.
[39] العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، شرح العقيدة الواسطية: ج2، ص299.
[40] الأيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف: ج3، ص465. السفاريني، محمد بن أحمد، لوامع الأنوار: ج2، ص394. اللالكائي، هبة الله بن الحسن، كرامات الأولياء: ص71 ـ 74، ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الحديثية: ص301.
[41] النووي، يحيى بن شرف، بستان العارفين: ص59 ـ 60.
[42] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الحديثية: ص301.
[43] فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، تفسير الرازي: ج21، ص73.
[44] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج8، ص4، وفي: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص140، بنحو من الاختصار. واُنظر: كرامات الأولياء للالكائي: ص87.
[45] اُنظر: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الحديثية: ص301.
[46] اُنظر: فخر الدين الرازي، محمد بن عمر، تفسير الرازي: ج21، ص73 ـ 74.
[47] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج3، ص37 ـ 38، ص51 ـ 52، النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج8، ص89 ـ 90. اللالكائي، هبة الله بن الحسن، كرامات الأولياء: ص83 ـ 85.
[48] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج7، ص111، وبنحوه في: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص192. واُنظر: اللالكائي، هبة الله بن الحسن، كرامات الأولياء: ص89.
[49] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج8، ص222 ـ 223. واُنظر: اللالكائي، هبة الله بن الحسن، كرامات الأولياء: ص86.
[50] ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ص158ـ 166.
[51] المصدر السابق: ص163ـ 164.
[52] المصدر السابق: ص164.
[53] ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم، النبوات: ص218.
[54] المصدر السابق: ص213.
[55] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الفتاوى الحديثية: ص301.
[56] السفاريني الحنبلي، محمد بن أحمد، لوامع الأنوار البهية: ج2، ص394.
[57] العطار الشافعي، حسن بن محمّد، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: ج2، ص481.
[58] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ج1، ص388.
[59] وقد تم نشر المقاطع على هذا الرابط: http://www.alukah.net/audio_books/11/15866/.
[60] لم نفهم استثناء الرافضي هنا وما مقصوده به، فإنْ كان المقصود هم الشيعة حيث تعارف منهم إطلاق اسم الرافضة عليهم، فلا معنى لهذا الاستثناء لأنّهم يثبتون الكرامات للأحياء والأموات، وإنْ كان اصطلاحاً آخر فلم يتبيّن لنا ما هو. اللّهم إلّا أنْ يكون مراده إلّا الرافض للحق مثلاً.
[61] الخادمى الحنفي، محمد بن محمد، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية: ج1، ص203.
[62] الرملي الشافعي، أحمد بن حمزة، فتاوى الرملي: ج4، ص382.
[63] القرطبي، محمد بن أحمد، التذكرة بأحوال الموتى: ج1، ص459 ـ 460. واُنظر: ابن قيم الجوزية، محمّد بن أبي بكر، الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل: ج1، ص35 ـ 36.
[64] آل عمران: الآية169ـ 171.
[65] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج6، ص352. الألباني، محمّد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2، ص187.
[66] النيسابوري مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج7، ص102.
[67] أبو داود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ج1، ص453.
[68] النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب: ج8، ص272.
[69] الحربي، إبراهيم بن إسحاق، غريب الحديث: ج1، ص67ـ 68.
[70] النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب: ج4، ص548.
[71] الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، وبذيله التخليص للذهبي: ج1، ص278.
[72] الألباني، ناصر الدين، إرواء الغليل: ج1، ص34 ـ 35. واُنظر: الألباني، محمّد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج4، ص32.
[73] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج2، ص401.
[74] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج4، ص307.
[75] ابن أبي الدنيا، عبد الله بن محمد، المنامات: ص10.
[76] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج8، ص162.
[77] اُنظر: ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ص164.
[78] اُنظر: المصدر السابق: ص165.
[79] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج5، ص12ـ 13.
[80] الظاهر أنّ المراد بها الزنابير.
[81] ابن عبد البرّ، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج2، ص87.
[82] ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم، اقتضاء الصراط المستقيم: ص373 ـ 374.
[83] اُنظر: السيوطي، جلال الدين، قطف الأزهار المتناثرة: ص286.
[84] الألباني، محمّد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2، ص423 ـ 431.
[85] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج4 ص172. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص324، وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك وصحّحه ووافقه الذهبي. اُنظر: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص الذهبي: ج3، ص177.
[86] حديث نزول الملك وإعطائه للنبيّ’ تربة حمراء من تراب كربلاء، صحّحه الألباني وأورد جملة من طرقه عن عدّة من الصحابة. اُنظر: الألباني، محمّد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2 ص465 ـ 466.
[87] المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير: ج1، ص265.
[88] السيوطي، جلال الدين، تاريخ الخلفاء: ص182.
[89]الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص192.
[90] انظر: النجاشي: أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنفي الشيعة: ص260. أبو علي, الفضل بن الحسن الطبرسي, إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1, ص102.
[91] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، فلاح السائل: ص158. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج1، ص291. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج1، ص222.
[92] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص165. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج8، ص216.
[93]اُنظر: الكلبايكاني، لطف الله الصافي، فقه الحج بحوث استدلالية في الحج: ج2، ص305.
[94] انظر: الصدوق, محمّد بن علي, من لا يحضره الفقيه: ج2, ص231.
[95]قال التفريشـي: «وذكره محمد بن علي بن بابويه في مشيخته كثيراً، وقال: رضي الله عنه». التفريش، مصطفى بن الحسين، نقد الرجال: ج4، ص280. وقال بحر العلوم: «وقد أكثر الرواية عنه في مشيخة الفقيه وسائر كتبه، وكلّما ذكره قال: رضي الله عنه». بحر العلوم، محمد مهدي، الفوائد الرجالية: ج3، ص308.
[96] اُنظر: بحر العلوم، محمد مهدي، الفوائد الرجالية: ج3، ص310.
[97] والمراد به كتاب منتقى الجمان للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني.
[98] والمراد به كتاب الحبل المتين للشيخ محمّد بن الحسين البهائي.
[99] والمراد به كتاب منهج المقال للشيخ محمد بن علي الأسترآبادي.
[100] والمراد به كتاب الرواشح السماوية للسيد محمّد باقر الداماد.
[101] والمراد به باب الألقاب من كتاب تلخيص الأقوال في معرفة الرجال, وهو الرجال الوسيط للشيخ محمّد بن علي الاسترابادي.
[102] والمراد به كتاب مشرق الشمسين للشيخ محمّد بن الحسين البهائي.
[103] بحر العلوم، محمد مهدي، الفوائد الرجالية: ج3، ص310.
[104] اُنظر: المجلسي، محمد تقي، روضة المتقين: ج5، ص838.
[105] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص177.
[106] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة: ص510.
[107] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج1، ص130.
[108] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص354.
[109] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص219. الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص400.
[110] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج3، ص92ـ 93.
[111] اُنظر: المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال في علم الرجال: ج8، ص26.
[112] اُنظر: الكلباسي، محمد بن محمد، الرسائل الرجالية: ج3، ص589، ص651. الداوري، مسلم، أُصول علم الرجال: ج2، ص402، ص420.
[113] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج19، ص317، ص330.
[114] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص183ـ 184.
[115] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص187.
[116] اُنظر: الداوري، مسلم، أصول علم الرجال: ج1، ص199، ص223.
[117] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج9، ص214.
[118] اُنظر: الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص190.
[119] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص117.
[120] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص188.
[121] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص428.
[122] اُنظر: المصدر السابق.
[123] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص147.
[124]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص254ـ 255.
[125]اُنظر: العلّامة الحلي، يوسف بن المطهر، خلاصة الأقوال: ص285.
[126] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج2، ص206.
[127] اُنظر: الزنجاني، موسى، الجامع في الرجال: ج11، ص166.
[128] اُنظر: المنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفّين: ص3.
[129]ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج6، ص112.
[130] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص199.
[131]اُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص90.
[132] الزنجاني، موسى، الجامع في الرجال: ج8، ص52.
[133]اُنظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص345.
[134]اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص149ـ ص150، ص183.
[135]اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ج1، ص228.
[136]اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج14، ص43.
[137]اُنظر: المصدر السابق: ج14، ص108.
[138]اُنظر: المصدر السابق: ج20، ص160.
[139] المصدر السابق: ج14، ص111.
[140] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص287.
[141] اُنظر: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص149ـ ص150، ص183.
[142]اُنظر: الأردبيلي، محمد بن علي، جامع الرواة: ج1، ص147.
[143] الزنجاني، موسى، الجامع في الرجال: ج11، ص165.
[144]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص316.
[145]اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص457.
[146]اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج20، ص141.
[147] التستري، محمد تقي، قاموس الرجال: ج10، ص345.
[148] يعني عصره متحد مع نجيح بن عبد الرحمن.
[149] الزنجاني، موسى، الجامع في الرجال: ج12، ص286.
[150] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص119.
[151] ابن الشهيد الثاني، حسن زين الدين، التحرير الطاووسي: ص315.
[152] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج17، ص191.
[153] المصدر السابق.
[154] المصدر السابق: ج7، ص192.
[155] التستري، محمد تقي، قاموس الرجال: ج9، ص329.
[156] المازندراني، محمد بن إسماعيل، منتهى المقال: ج6، ص80.
[157]اُنظر: الزنجاني، موسى، الجامع في الرجال: ج10، ص206 ـ 207.
[158] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص183.
[159] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج16، ص182 ـ 185.
[160]اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص334.
[161] الملاحف المعصفرة: وهي المصبوغة بالعُصفُر، وهو نبت معروف يُصبغ به، والظاهر أنّه يصبغ الثياب ونحوها بالصبغ الأحمر، والمراد أنّ الحيطان تُرى حمراء لشدّة احمرار الشمس في تلك الفترة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص750. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص581. مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط: ج2 ص605.
[162] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص189. الصدوق، محمد بن علي، علل الشـرائع: ج1، ص227 ـ 228.
[163] اُنظر: الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص138.
[164] اُنظر: المازندراني، محمد بن إسماعيل، منتهى المقال: ج4، ص201.
[165]اُنظر: العلّامة الحلي، يوسف بن المطهر، خلاصة الأقوال: ص119.
[166] اُنظر: الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص139. المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال: ج21، ص328 ـ 329.
[167]اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج6، ص187 ـ 188.
[168] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج2، ص262.
[169] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص92.
[170]اُنظر: المصدر السابق: ص107.
[171] مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث، مجلة تراثنا، العدد الثاني، السنة الأُولى، خريف سنة 1406هـ: ج2، ص145.
[172] المفيد، محمد بن محمد، الأمالي: ص321. الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص91. الصدوق، محمد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج1، ص268 ـ 269.
[173] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص31.
[174] المشغري، يوسف بن حاتم، الدر النظيم: ص560.
[175]اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص86.
[176] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، معالم العلماء: ص105.
[177] الحر العاملي، محمد بن الحسن، أمل الآمل: ج2، ص292.
[178] المصدر السابق.
[179]الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج3، ص352.
[180] المصدر السابق.
[181] المصدر السابق.
[182] المصدر السابق: ج3، ص353..
[183]المصدر السابق: ج3، ص353.
[184]ابن النديم، محمد بن أبي يعقوب، الفهرست: ص146.
[185] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص85. الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص79. الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص413.
[186] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص86.
[187] اُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص29، ص31.
[188] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص113.
[189] المفيد، محمد بن محمد، الأمالي (تحقيق علي أكبر غفاري): ص321.
[190] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص330.
[191] اُنظر: النحال، محمود بن عبد الفتاح، اتحاف المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي: ص469.
[192] عرفانيان، غلام رضا، مشايخ الثقات: ص34.
[193]الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج2، ص335.
[194]السمعاني، عبد الكريم بن محمد، الأنساب: ج1، ص151.
[195] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج7، ص353 ـ 354.
[196] وفي طبعة بتحقيق بهراد الجعفري، وإشراف علي أكبر الغفاري ص78، أبو الحسين أحمد بن عبد الله، وكان المحقّق قد أشار في مقدمة الكتاب عند ذكره لمشايخ ابن قولويه إلى أنّ أحمد ومحمّد قد يكونان شخصين، أو أنّهما شخصية واحدة وقد صُحّفت.
ولعلّ ما ورد في المتن هو الأصحّ بقرينة ما ورد في موضع آخر متقدّم على هذا، وهو ما ورد في ص153 بتحقيق القيومي، وفي ص74 بتحقيق الجعفري، وفيه أنّ الذي يحدّث عن عبد الرحمان الأسلمي هو محمّد وليس أحمد.
[197] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص160ـ 161.
[198] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص68، ج3، ص258، ج5، ص91.
[199] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج4، ص257.
[200] هكذا في المصدر المطبوع، والصحيح (دماً).
[201]ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهم أحداث الأسنان):ج1، ص505.ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص90.
[202] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص209.
[203] هكذا ورد عند الثعلبي (القاضي) وليس (القاص)، لكن مَن تقدّمه من علماء التاريخ والرجال كابن سعد، والبخاري، وابن أبي حاتم، أطبقوا على أنّ اسمه (سليم القاص).
[204]الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان: ج8، ص353.
[205] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج4، ص129. ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج4، ص216. ابن حبّان، محمد، الثقات: ج4، ص329.
[206] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، المحاضرات والمحاورات: ص79.
[207] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج4، ص157ـ 158.
[208] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص383ـ 384.
[209] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج10، ص330.
[210]ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص220.
[211] الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص395.
[212] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج3، ص11ـ 14.
[213] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص238.
[214] الجرجاني، عبد الله بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج2، ص266.
[215] الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص203. واُنظر: الجرجاني، عبد الله بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج2، ص266.
[216] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص349. واُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج7، ص263.
[217]الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج7، ص446.
[218] اُنظر: الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ج2، ص190.
[219] المصدر السابق: ج1، ص204.
[220]اُنظر: ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو، السنّة (تحقيق الألباني): ص388.
[221] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج4، ص129.
[222] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج4، ص216.
[223] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج4، ص329.
[224] ابن أبي العينين، أحمد بن إبراهيم، سؤالات ابن أبي العينين للشيخ الألباني: ص61.
[225] الألباني، محمد ناصر الدين، تمام المنّة: ص203.
[226] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، نزهة النظر: ص102.
[227] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج4، ص129. ابن حبّان، محمد، الثقات: ج4، ص329.
[228] النووي، يحيى بن شرف، المجموع شرح لمهذب: ج6، ص277.
[229] اُنظر: النووي، يحيى بن شرف، المنهاج في شرح صحيح مسلم: ج1، ص28.
[230] ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، مقدّمة ابن الصلاح: ص89.
[231] ابن جماعة، محمد بن إبراهيم، المنهل الروي: ص66. والطيبي، الحسين بن عبد الله، الخلاصة في أصول الحديث: ص90.
[232] اُنظر: الزركشي، محمد بن عبد الله، النكت على مقدّمة ابن الصلاح: ج3، ص376.
[233] اُنظر: التهانوي، ظفر أحمد، قواعد في علوم الحديث: ص223، ص358.
[234] اُنظر: شاكر، أحمد محمد، مقدّمته على كتاب المسح على الجوربين للقاسمي: ص5، ص13.
[235] وقد ذكر خلاصة كلامه ابن أبي العينين، فقال: «وقد جمع جلّ أقوالهم الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة، في بحث نشـره في مجلة كلية أُصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، بعنوان: (سكوت المتكلّمين في الرجال عن الراوي الذي لم يُجرح، ولم يأتِ بمتن منكر يُعدّ توثيقاً له)، ثمّ ختم البحث بقوله: فإذا علم هذا كلّه، اتضحت وجاهة ما أثبته من أنّ مثل البخاري، أو أبي زرعة، أو أبي حاتم، أو ابنه، أو ابن يونس المصري الصدفي، أو ابن حبّان، أو ابن عدي الجرجاني، أو الحاكم الكبير أبي أحمد، أو ابن النجار البغدادي، أو غيرهم ممَّن تكلّم أو صنّف في الرجال، إذا سكتوا على الراوي الذي لم يُجرح ولم يأتِ بمتن منكر، يُعدّ سكوتهم عنه من باب التوثيق والتعديل، ولا يُعدّ من باب التجريح والتجهيل، ويكون حديثه صحيحاً، أو حسناً، أو لا ينزل عن درجة الحسن إذا سَلِم من المغامز، والله أعلم». ابن أبي العينين، أحمد بن إبراهيم، مقدّمته على كتاب الضعفاء الصغير للبخاري: ص5ـ 6. كما أنّ أبا غدّة أشار لهذا الموضوع أيضاً في تحقيقه لكتاب قواعد في علوم الحديث: ص358.
[236]ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهم أحداث الأسنان):ج1، ص508. ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص90.
[237] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص487.
[238] البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة: ج6، ص471.
[239]اُنظر: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2638.
[240]اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص102.
[241] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص277.
[242] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الخصائص الكبرى: ج2، ص126.
[243] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص312.
[244] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص433.
[245] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج8، ص181.
[246] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج27، ص487 ـ 492.
[247] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص157.
[248] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ص276.
[249] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج10، ص314.
[250] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص177.
[251] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص227.
[252] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص312.
[253] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص487.
[254] اُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوّة: ج6، ص471.
[255] المصدر السابق: ج1، ص46.
[256] المصدر السابق ص47.
[257] السليماني، مصطفى، إتحاف النبيل: ج2، ص86.
[258] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص226.
[259] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص432.
[260] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج8، ص357.
[261] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج20، ص31.
[262] المصدر السابق: ج18، ص559.
[263]الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج6، ص309.
[264] الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج3، ص1078.
[265] السمعاني، عبد الكريم بن محمد، الأنساب: ج3، ص535.
[266] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، اللباب في تهذيب الأنساب: ج2، ص239.
[267] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج7، ص338.
[268] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج8، ص72.
[269] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج7، ص339.
[270] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص469.
[271] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج7، ص339.
[272] اُنظر: الجرجاني، عبد الله بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج2، ص330.
[273]المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج8، ص288.
[274] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج1، ص336.
[275] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص374.
[276] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص341 ـ 342. الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص659 ـ 660.
[277] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج4، ص209. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج3، ص139.
[278] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص273.
[279] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص433.
[280]اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص228ـ 229.
[281] الطبري، أحمد بن عبد الله، ذخائر العقبى: ص145.
[282] ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2635ـ 2636.
[283] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (291ـ 300هـ)، ج22، ص147.
[284] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، الملاحم والفتن: ص334.
[285] الصالحي، محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد: ج11، ص541.
[286] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (61ـ 80هـ)، ج5، ص16.
[287] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج10، ص110ـ 115.
[288] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص31. الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل: ج6، ص241.
[289] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص81 ـ 83.
[290] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص294.
[291] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص162.
[292] الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج5، ص222.
[293]الدولابي، محمد بن أحمد، الذرية الطاهرة: ص97.
[294] اُنظر: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2636.
[295]اُنظر: الدولابي، محمد بن أحمد، الذرية الطاهرة: ص97.
[296] اُنظر: الجرجاني، عبد الله بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج2، ص351، وج5، ص260.
[297] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج4، ص28.
[298] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، جامع بيان العلم وفضله: ص114.
[299] الدارقطني، علي بن عمر، سؤالات حمزة: ص203.
[300] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص151.
[301] اُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج2، ص307.
[302] اُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة: ج1، ص46ـ 47. السليماني، مصطفى بن إسماعيل، إتحاف النبيل: ج2، ص86 ـ 87.
[303] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج3، ص6.
[304] ابن حبّان، محمد، المجروحين: ج1، ص238.
[305] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج6، ص2.
[306] المصدر السابق: ج6، ص2.
[307] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج7، ص68 ـ 69.
[308]اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص69.
[309] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص227.
[310] ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2636.
[311]الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج5، ص245.
[312] أبو نعيم الأصبهاني،أحمد بن عبد الله، ذكر أخبار أصبهان: ج1، ص125. المصدر السابق: ج5، ص246.
[313]اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج1، ص57ـ 58.
[314] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص43.
[315] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص127ـ 128.
[316]ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج7، ص289. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج9، ص207.
[317]ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج7، ص289.
[318] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص82.
[319] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج9، ص207.
[320] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص586.
[321] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج8، ص371.
[322] هكذا في المطبوع والظاهر بعد التتبع والتحقيق أنّ شيخ علي بن عبيد الله الزاغوتي، هو علي بن أحمد بن البسـري البندار وليس السري، وهو الموافق لما ورد في تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي: ص560.
[323] الظاهر، بل الذي عليه التحقيق، هو أبو عبد الله بن بطة، وهو عبيد الله بن محمد العكبري الملقب بابن بطة، وكان ابن البسري آخر مَن روى عنه بالإجازة. اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج16، ص529. وهو الموافق لما ورد في تذكرة الخواص: ص560.
[324] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، التبصرة: ج2، ص14.
[325]ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2639.
[326] الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء: ج3، ص1031.
[327]الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (351ـ 380هـ)، ج26، ص439.
[328]اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج4، ص127ـ 128.
[329] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج11، ص67.
[330] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص248.
[331] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص340.
[332] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص271.
[333] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج7، ص378.
[334] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص713.
[335] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج11، ص200.
[336]المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج21، ص293. الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة: ج2 ص56.
[337] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج2، ص665.
[338] العسقلاني، أحمد بن حجر، مقدّمة فتح الباري: ص430.
[339] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص5.
[340] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج13، ص389.
[341] الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج1، ص586.
[342] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج2، ص141. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج6، ص239.
[343] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج2، ص127.
[344]اُنظر: ابن حيّان، عبد الله بن محمد، طبقات المحدّثين بأصبهان: ج4، ص29. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج9، ص367.
[345] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج5، ص420.
[346] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج5، ص376.
[347] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص121.
[348] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص132.
[349] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج9، ص367.
[350]ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر، بلاغات النساء: ص23.
[351]ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر، بلاغات النساء: ص24.
[352] البراقي النجفي، حسين بن أحمد، تاريخ الكوفة: ص293.
[353] اُنظر: ابن الفقيه، أحمد بن محمد، البلدان: ص224.
[354]اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص121.
[355] اُنظر: ابن حمدون، محمد بن الحسن، التذكرة الحمدونية: ج6، ص265.
[356] الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص45 ـ 46.
[357]الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج4، ص433.
[358] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص438.
[359] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج14، ص23.
[360] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (211ـ 220هـ)، ج15، ص442. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص300.
[361] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص445.
[362] الصالحي، محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد: ج11، ص541.
[363] الطبري، أحمد بن عبد الله، ذخائر العقبى: ص145.
[364] المصدر السابق: ص150.
[365] القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ج3، ص102.
[366] المصدر السابق: ج3، ص91.
[367] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص191.
[368] سبط بن الجوزي، يوسف بن فرغلي، مرآة الزمان: ج8، ص172.
[369] القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص165 ـ 166.
[370] الطبري، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص179.
[371] القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص166.
[372] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص212.
[373] القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص166.
[374] المصدر السابق.
[375]المصدر السابق.
[376] http://www.britannia.com/history/docs/ 99 -676.html.
[377] ابن نما، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص63.
[378] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص569. اُنظر: القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ج3، ص20، وقد صرّح بأنّ القائل هو أبو سعيد الخدري.
[379] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور: ج3، ص318.
[380] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج5، ص123. وروي بسند صحّحه السيوطي كما في كنز العمال: ج8، ص439 (بلفظ: عن ربيعة بن قسيط). وعند الذهبي في السيَّر: ج4، ص510 (ربيعة بن لقيط): «أنّه كان مع عمرو بن العاص عام الجماعة، وهم راجعون فمُطروا دماً عبيطاً، قال ربيعة: فلقد رأيتني أنصب الإناء فيمتلئ دماً عبيطاً، فظنّ الناس أنّها هي دماء الناس بعضهم في بعضهم. (وعند الذهبي: وظنّ الناس أنّها الساعة وماجوا)...».
وقال الذهبي أيضاً: «ورواه عمرو بن الحارث، عن يزيد، عنه: أنّهم كانوا حين قفلوا من العراق، فأمطرت السماء بدجلة دماً عبيطاً، فقالوا: القيامة وذكر نحوه».
[381] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (241ـ 250هـ)، ج18، ص17. والخبر أورده الطبري وغيره في تواريخهم. اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك: ج7، ص389. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج11، ص341.
[382] أبو المحاسن، يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهرة: ج5، ص298.
[383] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج14، ص183.
[384] المفيد، محمد بن محمد، الأمالي: ص323.
[385] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص161.
[386] المصدر السابق: ص188.
[387] المصدر السابق: ص160ـ 161.
[388] المصدر السابق: ص158ـ 160.
[389] قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، قصص الأنبياء: ص146. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج42، ص302.
[390] الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص69.
[391] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص388.
[392] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص151.
[393] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص273.
[394] الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج5، ص480.
[395] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص322.
[396] وهو ثقة وجيه, اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص441.
[397] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج22، ص52.
[398]الملاحف المعصفرة: وهي المصبوغة بالعُصفُر، وهو نبت معروف يُصبغ به، والظاهر أنّه يصبغ الثياب ونحوها بالصبغ الأحمر، والمراد أنّ الحيطان تُرى حمراء لشدّة احمرار الشمس في تلك الفترة. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج2، ص750. ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص581. مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط: ج2 ص605.
[399] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص222.
[400] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص353.
[401] المصدر السابق: ص428.
[402] المصدر السابق: ص332. اُنظر: التستري، محمد تقي، قاموس الرجال: ج9، ص421ـ 423.
[403] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج15، ص141ـ 142.
[404] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص112.
[405] قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج1، ص291. وعنه: المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج10، ص152. البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج5، ص173.
[406] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص218، وعنه: المجلسـي، محمد باقر، البحار: ج45، ص305. البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4، ص116.
[407] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص113.
[408] أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج2، ص667.
[409] والصحيح (ابن جريج).
[410] أبو العرب، محمد بن أحمد، المحن: ص161.
[411] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (291ـ 300هـ )، ج22، ص147.
[412] ابن طاووس، علي بن موسى، الملاحم والفتن: ص337.
[413] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص228.
[414] الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين×: ج2، ص266.
[415] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص119.
[416]اُنظر: الكنجي الشافعي، محمد بن يوسف، كفاية الطالب: ص444.
[417] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص113.
[418] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (291ـ 300هـ )، ج22، ص147.
[419] ابن طاووس، علي بن موسى، الملاحم والفتن: ص336ـ 337.
[420] ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2637.
[421] ابن سعد، محمد، طبقات ابن سعد: ص163.
[422] البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة: ج6، ص471.
[423] ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2637.
[424] ابن عساكر، علي بن الحسن، ترجمة الإمام الحسين×: ص362 ـ 363.
[425] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (291ـ 300هـ)، ج22، ص147.
[426] ابن طاووس، علي بن موسى، الملاحم والفتن: ص336.
[427] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص434.
[428]الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص314.
[429] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص102.
[430]ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهم أحداث الأسنان):ج1، ص506. ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص90ـ 91.
[431] أبو العرب، محمد بن أحمد، المحن: ص161.
[432] ابن عبد ربّه الأندلسي، أحمد بن محمد، العقد الفريد: ج4، ص361.
[433] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص113.
[434] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص214. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص129.
[435] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج9، ص480. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص444.
[436] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص170ـ 171.
[437] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص196.
[438] المصدر السابق.
[439] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (291ـ 300هـ)، ج22، ص274.
[440] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص390. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج11، ص319.
[441] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج3، ص355ـ 356. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص76.
[442] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص76.
[443] ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2637.
[444] اُنظر: الجرجاني، عبد الله بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج3، ص325.
[445] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج4، ص154.
[446] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص202.
[447] وسيأتي لاحقاً إمكان الاعتماد عليه.
[448] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج15، ص283.
[449] هكذا ورد في المصدر، لكن الظاهر هو عبد الله بن مسرة (بدون ياء)؛ وذلك لعدّة قرائن، أولها: إنّ عبد الله بن مسـرة هذا من علماء الأندلس، وابن عبد ربّه أندلسي أيضاً، فيقوى كون الرواية عنه لا عن غيره، خصوصاً أنّ ممّن روى عن عبد الله بن مسرّة هم الأندلسيون كما قال الذهبي في تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (281ـ 290هـ)، ج21، ص209ـ 210. وثانياً: إنّ الذي روى عنه ابن عبد ربّه يُلقب بأبي محمد، وعبد الله بن مسرّة يُلقب بأبي محمد أيضاً. وثالثاً: إنّ مَن عثرنا عليهم باسم عبد الله بن ميسـرة، هما: اثنان، أحدهما عبد الله بن ميسرة الكوفي الواسطي، الملقب بأبي ليلى الحارثي، ويُكنيه هشيم بابي إسحاق، وأبي عبد الجليل، والآخر هو عبد الله بن ميسرة الطهوي الملقب بابن أبي جميلة، وهذان مضافاً إلى أنّهما غير ملقبين بأبي محمد، فإنّه بعد تتبعنا لشيوخهما وتلامذتهما تبينّ أنّ طبقتهما لا تتناسب أنْ يكون أيّ منهما شيخاً لابن عبد ربّه الأندلسي؛ إذ الظاهر أنّهما توفّيا في القرن الثاني الهجري، بخلاف عبد الله بن مسرة المتوفي (286هـ)، فإنّه يتناسب أن يكون شيخ ابن عبد ربّه المتوفّي (328هـ).
[450]الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (281ـ 290هـ)، ج21، ص209.
[451] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص225. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج9، ص425.
[452] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج4، ص50.
[453]اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج4، ص51. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص138.
[454]اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص142. الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص115.
[455] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج3، ص16.
[456] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص598.
[457] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج7، ص272.
[458] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج21، ص485. الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص68.
[459] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج4، ص487.
[460] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص219.
[461] البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة: ج6، ص441.
[462] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص571.
[463]الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص149.
[464] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص229.
[465] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الخصائص الكبرى: ج2، ص126.
[466] ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2637.
[467] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص434.
[468] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص102.
[469] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج3، ص490ـ 491.
[470] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص118ـ 119.
[471] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص262.
[472] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج4، ص249.
[473]ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج4 ص259.
[474] اُنظر: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج3، ص60.
[475] اُنظر: المصدر السابق: ج2، ص239، ج2، ص250.
[476] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج4، ص249.
[477] الجرجاني، عبد الله بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج3، ص313.
[478] اُنظر: الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2، ص28.
[479] اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج2، ص238. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج2، ص509.
[480] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج6، ص316.
[481] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج3، ص403.
[482] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج3، ص576.
[483]ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهم أحداث الأسنان):ج1، ص507. ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص91.
[484] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص226.
[485]الذهبي، محمد بن أحمد، ذكر أسماء مَن تكلّم فيه وهو موثّق: ص148.
[486]الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص392.
[487] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص738.
[488] القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة: ج3، ص102.
[489]ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهم أحداث الأسنان):ج1، ص506. ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص90 ـ 91.
[490] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص229.
[491] اُنظر: الكنجي الشافعي، محمد بن يوسف، كفاية الطالب: ص443ـ 444.
[492] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج3، ص212ـ 230.
[493] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج3، ص288.
[494] اُنظر: التهانوي، أحمد، قواعد في علوم الحديث: ص349 ـ 350.
[495] اُنظر: المصدر السابق.
[496] ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير: ج6، ص215.
[497]الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء: ج6، ص2596.
[498] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص353.
[499] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص205.
[500] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب ج2، ص117.
[501] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص145.
[502] الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص220.
[503] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (291ـ 300هـ)، ج22، ص147.
[504] ابن طاووس، علي بن موسى، الملاحم والفتن: ص337.
[505] أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج2، ص662.
[506] ابن نما، جعفر بن محمد، مثير الأحزان: ص63.
[507] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص569.
[508] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج14، ص183.
[509] الدخان: 29.
[510] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص180.
[511] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج8، ص118. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج3، ص362.
[512] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص212.
[513] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص181.
[514] من الواضح أنّ هناك خلل في سياق العبارة؛ إذ إنّ لفظ (بكاؤهما) يدلّ على التثنية، في حين أنّ الإمام يتكلّم عن بكاء السماء فقط ولم يذكر الأرض، فإمّا أنْ تكون لفظة (الأرض) ساقطة، أو أنّ لفظ التثنية غير صحيح، والظاهر هو الثاني، بدليل أنّ صاحب البحار في (ج45، ص210) نقل الرواية بلفظ (بكاؤها)، كما أنّ الطريق الآخر للراوية الآتي ينصّ على لفظ (بكاؤها) أيضاً.
[515] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص181.
[516] المصدر السابق: ص185 ـ 186.
[517] الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص264.
[518] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج11، ص398.
[519] الدخان: 29.
[520]ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص180
[521] المصدر السابق: ص182.
[522]قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، قصص الأنبياء: ص222.
[523] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص182.
[524] المصدر السابق: ص188.
[525] المصدر السابق: ص182ـ 183.
[526]الأسترابادي النجفي، علي الحسيني، تأويل الآيات: ج1، ص302. البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج3، ص445.
[527] الأستربادي النجفي، علي الحسيني، تأويل الآيات: ج1، ص303.
[528] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص183.
[529] المصدر السابق: ص183.
[530] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج15، ص124ـ 128.
[531] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص161.
[532] المصدر السابق: ص161.
[533] المصدر السابق: ص183ـ 184.
[534] المصدر السابق: ص184.
[535] المصدر السابق: ص185.
[536] الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص99.
[537] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص185.
[538] المصدر السابق.
[539] المصدر السابق.
[540] المصدر السابق: ص186.
[541] المصدر السابق: ص187 ـ 188.
[542] اُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص298ـ 299.
[543] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص186.
[544] الملاحف المعصفرة، تقدّم سابقاً أنّها المصبوغة بالعُصفُر، وهو نبت معروف يُصبغ به، والظاهر أنّه يصبغ الثياب ونحوها بالصبغ الأحمر، والمراد أنّ الحيطان تُرى حمراء لشدّة احمرار الشمس في تلك الفترة.
[545]الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص189. الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ج1، ص227ـ 228.
[546] القمي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج2، ص291.
[547] مريم: 1.
[548] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص237.
[549] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص164.
[550] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص419.
[551] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص166.
[552] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج6، ص24ـ 25.
[553] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص166.
[554] المصدر السابق: ص166.
[555] المصدر السابق: ص167.
[556] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص575.
[557] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص54.
[558] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص167ـ 168.
[559] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص217.
[560] العلّامة الحلي، يوسف بن المطهر، خلاصة الأقوال: ص372.
[561] الخوئي, أبو القاسم, معجم رجال الحديث: ج11، ص259.
[562] اُنظر: الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص227.
[563] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص409.
[564] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص183.
[565] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص119. الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص92.
[566] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج15، ص124ـ 128.
[567] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص161.
[568] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج7، ص199، وما بعدها.
[569] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص161.
[570] المصدر السابق: ص183.
[571] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص97ـ 98. النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص34ـ 35.
[572] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص257.
[573] اُنظر: الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص339ـ 340.
[574] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص182.
[575] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص197. الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص145.
[576] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص158. الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص336.
[577] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص188.
[578] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص253.
[579] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص104.
[580] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج5، ص340.
[581] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص311.
[582] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص181.
[583] المصدر السابق.
[584] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج16، ص182ـ 185.
[585] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص334.
[586] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج20، ص236، ص238 ـ 239. التستري، محمد تقي، قاموس الرجال: ج10، ص464.
[587] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص431.
[588] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص184.
[589] المصدر السابق: ص185.
[590] الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص99.
[591] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص185.
[592] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص330 ـ 331.
[593]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص119. الطوسي، محمد بن الحسن، رجال الطوسي: ص334.
[594] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص184.
[595] المصدر السابق: ص167.
[596] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص575.
[597] اُنظر: الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص285.
[598] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج15، ص67ـ 68. الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضـره الفقيه: ج2، ص598.
[599] اُنظر: المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال في علم الرجال: ج19، ص184.
[600]الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج5، ص512.
[601]الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص598.
[602] النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص55.
[603] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص54.
[604] اُنظر: المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال في علم الرجال: ج7، ص246ـ 254.
[605] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص181.
[606] المصدر السابق: ص182.
[607] الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج24، ص17.
[608] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص97ـ 98. النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص34ـ 35.
[609] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص257.
[610] المصدر السابق: ص80.
[611] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج16، ص244ـ 245.
[612] اُنظر: الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص339ـ 340.
[613] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص325. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج17، ص325.
[614] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص182ـ 183.
[615] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص97ـ 98. النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص34ـ 35.
[616]اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج11، ص129ـ 137.
[617] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص270.
[618]الأستربادي النجفي، علي الحسيني، تأويل الآيات: ج1، ص302. البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج3، ص445.
[619] الأستربادي النجفي، علي الحسيني، تأويل الآيات: ج1، ص303.
[620] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص183.
[621] اُنظر: الوحيد البهبهاني، محمد باقر، تعليقة على منهج المقال: ص339ـ 340.
[622]ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص167.
[623]ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج4، ص154. وانظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، تفسير القرآن العظيم: ج10، ص3289.
[624] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج7، ص270ـ 271.
[625] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج4، ص293.
[626] الأرنؤوط، شعيب بن محرم، ومعروف، بشّار عوّاد، تحرير التقريب: ج2، ص362.
[627] ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: ص77.
[628] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج8، ص110.
[629]البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج8، ص17.
[630] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج8، ص365.
[631] اُنظر: ابن أبي العينين، أحمد بن إبراهيم، سؤالات ابن أبي العينين للشيخ الألباني: ص63.
[632]ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج6، ص2.
[633] المصدر السابق: ج6، ص2.
[634] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج7، ص68ـ 69.
[635] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص69.
[636] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص227.
[637] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج4، ص154.
[638] اُنظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج16، ص141.
[639] اُنظر: الماوردي، علي بن محمد، النكت والعيون: ج5، ص253.
[640] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج7، ص270 ـ 271.
[641] اُنظر: المصدر السابق: ج9، ص328.
[642] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص206.
[643] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص118.
[644] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص65.
[645] اُنظر: ابن شاهين، عمر بن أحمد، تاريخ أسماء الثقات: ص256.
[646] الفسوي، يعقوب بن سفيان، المعرفة والتاريخ: ج3، ص175.
[647] ابن حبّان، محمد، المجروحين: ج3، ص100.
[648] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص382.
[649] الألباني، محمد ناصر الدين، إرواء الغليل: ج3، ص63.
[650] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج64، ص217.
[651] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور: ج4، ص264.
[652]اُنظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج10، ص220.
[653]الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (521ـ 540هـ)، ج36، ص151.
[654] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج1، ص373.
[655] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج2، ص51ـ 52. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج16، ص388. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج5، ص80.
[656]الدارقطني، علي بن عمر، سؤالات الحاكم للدارقطني: ص108. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج6، ص390.
[657] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج6، ص390.
[658] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج5، ص376.
[659] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج2، ص238.
[660] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص60.
[661] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج5، ص191.
[662] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج5، ص165.
[663] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص181.
[664] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج8، ص323. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص29.
[665] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج4، ص154.
[666] اُنظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج16، ص141.
[667] اُنظر: الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان: ج8، ص353.
[668] اُنظر: البغوي، الحسين بن مسعود، معالم التنزيل: ج4، ص152.
[669] اُنظر: سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص561.
[670] اُنظر: الزرندي الشافعي، محمد بن يوسف، معارج الوصول إلى فضل آل الرسول: ص99.
[671] اُنظر: ابن البطريق، يحيى بن الحسن، عمدة صحاح الأخبار: ص405.
[672] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص203.
[673] اُنظر: البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4، ص153.
[674] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج25، ص160.
[675] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج9، ص50
[676]اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص158. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص55.
[677] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (201ـ 210هـ)، ج14، ص229.
[678] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج5، ص244.
[679]الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (211ـ 220هـ) ج15، ص142.
[680] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، غُنية الملتمس إيضاح المشتبه: ص262.
[681] اُنظر: الدمشقي، محمد بن عبد الله، توضيح المشتبه: ج5، ص150.
[682] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (201ـ 210هـ)، ج14، ص229.
[683] ابن الجزري، محمد بن محمد، غاية النهاية في طبقات القرّاء: ج1، ص334.
[684] اُنظر: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك: ج21، ص241.
[685] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص231.
[686] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص368.
[687]ابن شاهين، عمر بن أحمد، تاريخ أسماء الثقات: ص63.
[688] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج2، ص486.
[689] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج5، ص264. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج1، ص273ـ 274.
[690] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص97.
[691]الأرنؤوط، شعيب بن محرم، ومعروف، بشّار عوّاد، تحرير التقريب: ج1، ص136 ـ 137.
[692] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص225.
[693]ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2634.
[694] اُنظر: الكنجي الشافعي، محمد بن يوسف، كفاية الطالب: ص436 ـ 437.
[695] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص312.
[696] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (521ـ 540هـ)، ج36، ص278 ـ 279.
[697] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج2، ص140.
[698] اُنظر: السمعاني، عبد الكريم بن محمد، الأنساب: ج2، ص119. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، اللباب في تهذيب الأنساب: ج1، ص309. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (381ـ 400هـ)، ج27، ص175.
[699] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص185. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج4، ص290ـ 292.
[700] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج11، ص237.
[701] اُنظر قوليهما في: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج11، ص237ـ 238. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج4، ص291ـ 292.
[702]الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج11، ص237.
[703] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج2، ص319
[704]اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص554.
[705] ابن حبان، محمد، المجروحين: ج3 ص155. وانظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص554.
[706] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج3، ص177.
[707] اُنظر: المصدر السابق: ج9، ص190.
[708] أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، دلائل النبوة: ص581ـ 582.
[709] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الخصائص الكبرى: ج2، ص126.
[710] اُنظر: الطبري، أحمد بن عبد الله، ذخائر العقبى: ص97. ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص566.
[711] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص670. وقد ذكر الخطيب هذا القول وقصّته بتفصيل أكثر، اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج3، ص237.
[712] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج3، ص238. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (351ـ 380هـ)، ج26، ص127.
[713] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ: ج3، ص926.
[714] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج3، ص240. الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج16، ص20.
[715] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج3، ص240.
[716] الدارقطني، علي بن عمر، سؤالات الحاكم للدارقطني: ص125.
[717] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج14، ص46ـ 47، ص111.
[718] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص151.
[719] اُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج2، ص307.
[720] اُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة: ج1، ص46ـ 47. السليماني، مصطفى بن إسماعيل، إتحاف النبيل: ج2، ص86ـ 87.
[721] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج3، ص6.
[722] ابن حبّان، محمد، المجروحين: ج1، ص238.
[723]ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: ص232.
[724]اُنظر: العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص281.
[725] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج8، ص308.
[726] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص186.
[727]الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج2، ص177.
[728] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج3، ص410 ـ 411.
[729] البخاري، محمد بن إسماعيل، الضعفاء الصغير: ص56.
[730] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج1، ص234.
[731] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج2، ص35.
[732] ابن حبّان، محمد، المجروحين: ج1، ص174.
[733]ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج3، ص311.
[734] الشجري، يحيى بن الحسين، الأمالي: ج2، ص120.
[735] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج2، ص319
[736]اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص554.
[737] ابن حبان، محمد، المجروحين: ج3 ص155. وانظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص554.
[738]اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص294.
[739]المرعشي، شهاب الدين، تعليقات على إحقاق الحق: ج27، ص376.
[740] الدخان: الآية29.
[741] يوسف: الآية82.
[742] محمد: الآية4.
[743] اُنظر: المرتضى، علي بن الحسين، الأمالي: ص38. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير: ج7، ص116. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج16، ص140.
[744] اُنظر: المرتضى، علي بن الحسين، الأمالي: ص38 ـ 39. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير: ج7، ص116 ـ 117. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج19، ص139 ـ 140.
[745] اُنظر: المرتضى، علي بن الحسين، الأمالي: ص38 ـ 39.
[746] اُنظر: المرتضى، علي بن الحسين، الأمالي: ص39 ـ 40. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير: ج7، ص116. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج19، ص139 ـ 140.
[747] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج7، ص105.
[748] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير: ج7، ص116.
[749] المصدر السابق.
[750] المرتضى، علي بن الحسين، الأمالي: ص40.
[751] اُنظر: المصدر السابق: ص40 ـ 41.
[752] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج25، ص161ـ 163. واُنظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج16، ص140ـ 141. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج4، ص153. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور: ج6، ص30 ـ 31.
[753] المصادر السابقة.
[754] المصادر السابقة.
[755] المصادر السابقة.
[756] اُنظر: المصادر السابقة.
[757] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص254.
[758] الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص299.
[759] اُنظر: البروجردي، حسين، جامع أحاديث الشيعة: ج3، ص480، ج4، ص418 ـ 419.
[760] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج25، ص160.
[761]ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج4، ص154. وانظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، تفسير القرآن العظيم: ج10، ص3289.
[762] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور: ج2، ص31.
[763] القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج16، ص142.
[764] المصدر السابق.
[765] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص181.
[766] المصدر السابق: ص182ـ 183.
[767] المصدر السابق.
[768] من الواضح أنّ هناك خلل في سياق العبارة؛ إذ إنّ لفظ (بكاؤهما) يدلّ على التثنية، في حين أنّ الإمام يتكلّم عن بكاء السماء فقط ولم يذكر الأرض، فإمّا أنْ تكون لفظة (الأرض) ساقطة، أو أنّ لفظ التثنية غير صحيح، والظاهر هو الثاني، بدليل أنّ صاحب البحار في: (ج45، ص210) نقل الرواية بلفظ (بكاؤها)، كما أنّ الطريق الآخر للراوية الآتي ينص على لفظ (بكاؤها) أيضاً.
[769] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص181.
[770] المصدر السابق: ص185.
[771]الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص189. الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ج1، ص227ـ 228.
[772] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص222.
[773] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص181ـ 182.
[774] المصدر السابق: ص160ـ 161.
[775] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص132.
[776] القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ج3، ص169 ـ 170.
[777] المصدر السابق: ج3، ص174.
[778] ابن سعد، محمد، طبقات ابن سعد: ج1، ص507.
[779] اُنظر: أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء: ج2، ص276. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج2، ص667.
[780]اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص209.
[781] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص114.
[782] اُنظر: أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج2، ص667.
[783]هكذا في المطبوع، والظاهر بعد التتبع والتحقيق أنّ شيخ علي بن عبيد الله الزاغوتي هو: علي بن أحمد بن البسري البندار وليس السـري، وهو كذلك في تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي: ص560.
[784] الظاهر، بل الذي عليه التحقيق هو: أبو عبد الله بن بطة، وهو عبيد الله بن محمد العكبري الملقّب بابن بطة، وكان ابن البسري آخر مَن روى عنه بالإجازة. اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج16، ص529. وهو الموافق لما ورد في تذكرة الخواص لسبط بن الجوزي: ص560.
[785] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، التبصرة: ج2، ص15.
[786] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص228.
[787] المصدر السابق: ج39، ص493.
[788] الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص102ـ 103.
[789] المصدر السابق.
[790] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص679.
[791] اُنظر: المصدر السابق: ص238.
[792]اُنظر: المصدر السابق: ج2، ص266.
[793] اُنظر: المصدر السابق: ج2، ص85.
[794] الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص211. الزرندي الشافعي، محمد بن يوسف، معارج الوصول إلى فضل آل الرسول: ص98.
[795] اُنظر: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص569.
[796] اُنظر: سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص: ج2، ص231.
[797]ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، التبصرة: ج2، ص15.
[798] ابن سعد، محمد، طبقات ابن سعد: ج1، ص508.
[799] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص132.
[800] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج11، ص366.
[801] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص400.
[802] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص344.
[803]المصدر السابق: ص220. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج10، ص296.
[804] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص228.
[805] اُنظر: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2639.
[806] الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين: ج2، ص266.
[807] المصدر السابق: ج2، ص268.
[808] المصدر السابق: ج2، ص100.
[809] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص156. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص520.
[810] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص520.
[811] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج13، ص184ـ 185.
[812] اُنظر: الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين (مقدّمة تحقيق الكتاب في طبعته الثانية): ص19.
[813] أبو العرب، محمد بن أحمد، المحن: ص162.
[814] الحموي، ياقوت، معجم البلدان: ج2، ص8.
[815] العجلي، أحمد بن عبد الله، معرفة الثقات: ج2، ص254.
[816] ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص91. ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهم أحداث الأسنان):ج1، ص508.
[817] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص227.
[818]اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص432.
[819] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص15.
[820] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج10، ص400 ـ 401.
[821] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج21، ص129. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص703.
[822]اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج1، ص298.
[823] ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص91.
[824] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص226.
[825] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص113.
[826] البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة: ج6، ص472.
[827] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص226.
[828] المصدر السابق.
[829] الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص102.
[830]اُنظر: ابن حبان، محمد، الثقات: ج9 ص206. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج10، ص264.
[831] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص294.
[832] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص212.
[833]اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج7، ص335. الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص47. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص703.
[834] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص197.
[835] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص113.
[836]اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج3، ص349. ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج8، ص179.
[837]ابن حبّان، محمد، الثقات: ج9، ص172.
[838] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص423. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص98.
[839] الملاحف المعصفرة، تقدّم أنّها المصبوغة بالعُصفُر، وهو نبت معروف يُصبغ به، والظاهر أنّه يصبغ الثياب ونحوها بالصبغ الأحمر، والمراد أنّ الحيطان تُرى حمراء لشدّة احمرار الشمس في تلك الفترة. ويؤيد ذلك أنّ الخبر أعلاه نقله ابن حجر الهيتمي من طريق عثمان بن أبي شيبة أيضاً، بلفظ: «أن السماء مكثت بعد قتله سبعة أيام ترى على الحيطان كأنها ملاحف معصفرة من شدّة حمرتها وضربت الكواكب بعضها بعضاً». ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص569.
[840] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص114.
[841] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص227.
[842] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص432.
[843] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص312.
[844] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج2، ص444. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص664.
[845] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج9، ص11ـ 12.
[846] البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج1، ص310.
[847] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج1، ص125ـ 126.
[848] اُنظر: المصدر السابق: ج1، ص125ـ 126.
[849]ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج6، ص274.
[850] ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: ج1، ص361.
[851] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص230.
[852]اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص434ـ 435.
[853]اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص313.
[854] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص103.
[855] اُنظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج4، ص154.
[856]الدولابي، محمد بن أحمد، الذرية الطاهرة: ص97.
[857] اُنظر: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2636.
[858] الشجري، يحيى بن الحسين، الأمالي الخميسية: ج2، ص120.
[859] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، لسان الميزان: ج2، ص319.
[860]اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص554.
[861] ابن حبان، محمد، المجروحين: ج 33ص155. وانظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص554.
[862] الشجري، يحيى بن الحسين، الأمالي الخميسية: ج2، ص121.
[863]ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج4، ص154. وانظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، تفسير القرآن العظيم: ج10، ص3289.
[864] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج4، ص154.
[865] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج64، ص217.
[866] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان: ج25، ص160.
[867] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنّة: ج4، ص560.
[868] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص219.
[869] ابن الوزير، محمد بن إبراهيم، العواصم والقواصم: ج8، ص56ـ 57.
[870] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، التبصرة: ج2، ص16.
[871] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج1، ص424.
[872] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك: ج4، ص296. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص185. ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2639.
[873] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص398.
[874] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص468.
[875] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص173، ج3، ص224.
[876] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص338. الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص143ـ 144. اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص328.
[877] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الرسل والملوك: ج4، ص296. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص185.
[878] لم نقف على راوٍ بهذا الاسم، ولعلّ الصحيح هو عبد الملك بن موسى كما تقدّم معنا في سند ابن الجوزي الجد.
[879] سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص560.
[880] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص90.
[881] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص209.
[882]البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج3، ص337.
[883] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص228.
[884]اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص101ـ 102.
[885] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص433.
[886] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص114.
[887] اُنظر: أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج2، ص667.
[888] اُنظر: الكنجي الشافعي، محمد بن يوسف، كفاية الطالب: ص444.
[889] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي (تحقيق أحمد محمد شاكر): ج1، ص16.
[890] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد (تحقيق أحمد محمد شاكر): ج1، ص202.
[891] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج1، ص155، ج2، ص250.
[892] اُنظر: المصدر السابق: ج3، ص255، ص257، ص298، ج4، ص18، ص20، ص31، ص57، ص80، ص82، ص84، ص94، ج5، ص16، ص19، ص23، ص25، ص27، ص54، إلى غير ذلك من الموارد العديدة جداً التي بيّن فيها الهيثمي أنّ ابن لهيعة حسن الحديث.
[893] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، اللآلئ المصنوعة: ج1، ص225. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، النكت البديعات: ص185ـ 186.
[894] اُنظر: الفتني، محمد بن طاهر، تذكرة الموضوعات: ص185.
[895] اُنظر: المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير: ج1، ص641.
[896] اُنظر: الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار: ج5، ص101.
[897] الألباني، محمد ناصر الدين، جلباب المرأة المسلمة: ص59.
[898] العسقلاني، أحمد بن حجر، تقريب التهذيب: ج1، ص526.
[899] الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2، ص24.
[900] هادي، عصام موسى، محدّث العصر الإمام الألباني كما عرفته: ص78ـ 79.
[901] اُنظر: المصدر السابق.
[902] أبو إسحاق الحويني، حجازي محمّد شريف، بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن: ج1، ص32.
[903] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج3، ص64.
[904] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج3، ص275.
[905]ابن حبّان، محمد، الثقات: ج4، ص178.
[906] اُنظر: الأرنؤوط، شعيب بن محرم، ومعروف، بشّار عوّاد، تحرير التقريب: ج1، ص337.
[907] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص197.
[908] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص226.
[909]اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص432.
[910] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص229.
[911] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص694.
[912]اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة: ص532.
[913]قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج3، ص1144.
[914] اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج2 ص551، وما بعدها.
[915] وفي كتاب الأمالي وكذلك كمال الدين للشيخ الصدوق: (النحول) بدل البجول.
[916] قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج3، ص1145ـ 1147. واُنظر: الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص694ـ 696. الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة: ص535.
[917] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج13، ص70.
[918] الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص220.
[919] سبط بن الجوزي، يوسف بن فرغلي، مرآة الزمان: ج8، ص172.
[920] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص218.
[921] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص305.
[922] اُنظر: البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4، ص116.
[923] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص305.
[924] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص160ـ 161.
[925] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، التلخيص الحبير: ج5، ص84.
[926] الشربيني، محمد بن أحمد، مغني المحتاج: ج1، ص320.
[927] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص208.
[928] المجلسي، محمد باقر، مرآة العقول: ج14، ص138.
[929] آملي، حسن حسن زاده، دروس معرفة الوقت والقبلة: ص85.
[930] ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، حاشية ردّ المحتار: ج2، ص181.
[931] الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي: ج1، ص405.
[932] النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين: ج1، ص598.
[933] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص434.
[934] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص229.
[935] اُنظر: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2636.
[936] الطبري، أحمد بن عبد الله، ذخائر العقبى: ص145.
[937] اُنظر: الصالحي، محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد: ج11، ص541.
[938] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج1، ص69. الأرنؤوط، شعيب بن محرم، ومعروف، بشّار عوّاد، تحرير التقريب: ج1، ص75.
[939] اُنظر: المصدر السابق: ج3، ص347ـ 348.
[940] الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفاظ: ج1، ص350ـ 351.
[941] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج10 ص290ـ 291.
[942]اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص172.
[943] الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ص747.
[944] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص218.
[945] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص305.
[946] اُنظر: البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4، ص116.
[947]المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص435.
[948] أبو الحسين، محمد بن الحسين بن الفضل القطان.
[949] عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي.
[950] يعقوب بن سفيان الحافظ.
[951] اُنظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة: ج6، ص472.
[952] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص230.
[953] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص119.
[954]اُنظر: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2639.
[955] ابن حنبل، أحمد، العلل ومعرفة الرجال: ج1، ص450.
[956] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج17، ص331ـ 332.
[957] اُنظر: المصدر السابق: ج15، ص531ـ 532.
[958] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج32، ص324ـ 335.
[959] المصدر السابق: ج14، ص512ـ 513.
[960] السلمي، محمد بن الحسين، سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني: ص99. الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج2، ص622.
[961] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج3، ص143.
[962] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص234. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص79.
[963] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص449.
[964] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص197.
[965] اُنظر: السليماني، مصطفى، إتحاف النبيل: ج2، ص98.
[966]أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، ذكر أخبار أصبهان: ج2، ص182ـ 183. اُنظر: أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج2، ص667.
[967]اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج4، ص68. لكنّه جاء بلفظ: (فصار ورسه دماً). والظاهر أنّه من خطأ النُّسّاخ، خصوصاً أنّه رواها عن أبي نعيم، وعند أبي نعيم رماداً، كما نقلنا أعلاه.
[968] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص231.
[969]المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص345.
[970]اُنظر: ابن حيّان، عبد الله بن محمد، طبقات المحدّثين بأصبهان: ج2، ص186. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج4، ص68.
[971]ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى، الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة في من قبض رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وهم أحداث الأسنان):ج1، ص509. ابن سعد، محمد، ترجمة الإمام الحسين× (من طبقات ابن سعد): ص91.
[972] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص230.
[973] اُنظر: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2639ـ 2640.
[974]اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص103.
[975]اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج1، ص372. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص11.
[976]ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج6، ص308.
[977] اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج9، ص363.
[978]ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: ج1، ص361.
[979] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص230.
[980] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص103، لكنه ذكر بدل كلمة (النيران) (المرار).
[981]اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص434ـ 435.
[982] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص313.
[983] أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، ذكر أخبار أصبهان: ج2، ص183. اُنظر: أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، معرفة الصحابة: ج2، ص668.
[984] اُنظر: ابن حيّان، عبد الله بن محمد، طبقات المحدّثين بأصبهان: ج2، ص186. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج4، ص68.
[985]الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص220.
[986] الظاهر أنّ الصحيح هو أبو الحسين محمد بن الفضل القطان، بقرينة الروايات السابقة على هذه الرواية، وبقرينة أنّ شيخ البيهقي الذي يروي عن عبد الله بن جعفر هو أبو الحسين محمد بن الفضل القطان، وبقرينة أنّ ابن عساكر وابن العديم نقلوها عن البيهقي برواية القطان المشار إليه.
[987] الظاهر هو جميل بن مرّة بقرائن أوضحناها في ترجمة الرجل.
[988] البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة: ج6، ص472.
[989] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص231. وابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2641.
[990] المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص435. الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: حوادث وفيات (61ـ 80هـ)، ج5، ص16. اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص313.
[991] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الخصائص الكبرى: ج2، ص126.
[992] اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص103.
[993] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج5، ص131.
[994]اُنظر: ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج2، ص518.
[995]اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج6، ص146.
[996] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج1، ص297.
[997] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص166.
[998] وهو حافظ ثقة متقن. اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج4، ص1282ـ 1283.
[999] هكذا في المطبوع من كتاب المنتظم، وأمّا في المطبوع من كتاب الردّ على المتعصب العنيد، فجاء باسم: أبو الوصني، والظاهر أنّ الصحيح هو أبو الوضيء، وهوعبّاد بن نسيب القيسي، فقد روى عنه جميل بن مرّة، ثمّ إنّ في نُسخ تذكرة الخواص أيضاً يوجد اختلاف وخلط في الراوي المباشر كما مرّ، بل في بعض النُّسخ جعلهما اثنان: فقال: أبو الوضي، ومروان بن الوضين، ولعلّه من إضافات النُّسّاخ. اُنظر: سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص (تحقيق حسين تقي زادة): ج2 ص211، وطبعة دار نينوى: ص267. واُنظر أيضاً: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الرد على المتعصب العنيد: ص57. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج5، ص342.
[1000] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الرد على المتعصب العنيد: ص57. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج5، ص342. سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص (تحقيق حسين تقي زادة): ج2 ص211، وطبعة دار نينوى: ص267.
[1001] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج14، ص169ـ 170.
[1002] ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص218.
[1003] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج35، ص305.
[1004]اُنظر: البحراني، هاشم بن سليمان، مدينة المعاجز: ج4، ص116.
[1005] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج6، ص31.
[1006] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج11، ص102.
[1007] انظر: الكليني, محمّد بن يعقوب, الكافي: ج4 ص5.
[1008] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص314.
[1009] الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص216.
[1010]النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص396.
[1011] ولادته كانت في سنة (297هـ) ووفاته في سنة (387هـ). اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج5، ص466. اُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص188.
[1012] اُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج7، ص188.
[1013] الزنجاني، موسى، الجامع في الرجال: ج12، ص288.
[1014] اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الفهرست: ص73.
[1015] الزنجاني، موسى، الجامع في الرجال: ج1، ص129.
[1016] اُنظر: النجاشي، أحمد بن علي، فهرست أسماء مصنّفي الشيعة: ص333.
[1017] الزنجاني، موسى، الجامع في الرجال: ج11، ص475.
[1018] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج9، ص294. الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص150.
[1019] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج9، ص14ـ 15.
[1020] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص203.
[1021] اُنظر: المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال: ج29، ص55 ـ 66. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج8، ص332ـ 337.
[1022] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص314ـ 316.
[1023] اُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج6، ص23.
[1024]اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج4، ص305، ص307.
[1025] اُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم رجال الحديث: ج4، ص57.
[1026] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج11، ص245ـ 256.
[1027] اُنظر: ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص213.
[1028] ابن حمزة، محمد بن علي، الثاقب في المناقب: ص330.
[1029]قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج1، ص254.
[1030] اُنظر: العاملي، علي بن يونس، الصراط المستقيم: ج2، ص179.
[1031] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص131.
[1032] الطبري، محمد بن جرير، دلائل الإمامة: ص180.
[1033] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص108.
[1034] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص192.
[1035] اُنظر: ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2599.
[1036] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج6، ص409.
[1037]اُنظر: الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص189.
[1038] الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص215.
[1039] اُنظر: المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج14، ص122ـ 123.
[1040] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص466.
[1041] اُنظر: الرحمة، حكمت، دراسة في حديث السفينة على مباني أهل السنّة: ص188ـ 195.
[1042] الفسوي، يعقوب بن سفيان، المعرفة والتاريخ: ج3، ص14.
[1043] ابن حنبل، أحمد بن حنبل، سؤالات أبي داوُد لأحمد بن حنبل: ص199.
[1044] اُنظر: العلائي، خليل بن كيكلدي، جامع التحصيل في أحكام المراسيل: ص113. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، طبقات المُدلّسين: ص13، ص33.
[1045] الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة: ج4، ص403.
[1046] اُنظر: الأرنؤوط، شعيب بن محرم، ومعروف، بشّار عوّاد، تحرير التقريب: ج1، ص40.
[1047] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج4، ص317. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص421.
[1048] الشجري، يحيى بن الحسين، الأمالي الخميسية: ج2، ص115.
[1049]اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص107.
[1050] الزرندي الحنفي، محمد بن يوسف، نظم درر السمطين: ص217. اُنظر: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص565ـ 566.
[1051] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج17، ص639.
[1052] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج3، ص945.
[1053]الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج5، ص95.
[1054] الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج2، ص653ـ 654.
[1055] اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج1، ص107. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص57.
[1056] البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج1، ص57.
[1057]ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج7، ص220.
[1058]اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج1، ص176. ابن حبّان، محمد، صحيح ابن حبّان: ج12، ص11.
[1059]اُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص107ـ 108.
[1060]اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج5، ص346. ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج5، ص281.
[1061] اُنظر: ابن حبّان، محمد، الثقات: ج7، ص88.
[1062] اُنظر: ابن حبّان، محمد، صحيح ابن حبّان: ج12، ص11.
[1063]اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، التاريخ الكبير: ج1، ص176.
[1064] ابن أبي حاتم الرازي، عبد الرحمن بن محمد، الجرح والتعديل: ج8، ص18.
[1065] ابن حبّان، محمد، الثقات: ج5، ص363.
[1066]اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص718.
[1067] ابن العديم، عمر بن أحمد، بُغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2597ـ 2598.
[1068]ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص93.
[1069]الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج22، ص303.
[1070] اُنظر: السمعاني، عبد الكريم بن محمد، الأنساب: ج3، ص300. الذهبي، محمد بن أحمد، تذكرة الحفّاظ: ج4، ص1266ـ 1267.
[1071] ابن نقطة، محمد بن عبد الغني، تكملة الإكمال: ج2، ص413.
[1072]الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج7، ص288ـ 289.
[1073] اُنظر: المصدر السابق: ج11، ص126.
[1074] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج1، ص190.
[1075] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج14، ص173ـ 181. المزي، يوسف بن عبد الرحمن، تهذيب الكمال: ج31، ص419ـ 434. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج11، ص213ـ 218.
[1076] ابن معين، يحيى، تاريخ ابن معين برواية الدارمي: ص232.
[1077] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج14، ص174.
[1078] اُنظر: المصدر السابق.
[1079] اُنظر: المصدر السابق.
[1080] اُنظر: المصدر السابق.
[1081] اُنظر: المصدر السابق: ج14، ص175.
[1082]اُنظر: المصدر السابق: ج14، ص175.
[1083]اُنظر: المصدر السابق: ج14، ص175.
[1084] الجرجاني، عبد الله بن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج7، ص238.
[1085] المصدر السابق: ج7، ص239.
[1086] السقاف، حسن بن علي، تناقضات الألباني الواضحات: ج3، ص163.
[1087]اُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج4، ص154ـ 155.
[1088] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج1، ص741.
[1089] الذهبي، محمد بن أحمد، الكاشف: ج2، ص84.
[1090] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج5، ص317.
[1091] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تقريب التهذيب: ج2، ص189.
[1092] الأرنؤوط، شعيب بن محرم، ومعروف، بشّار عوّاد، تحرير التقريب: ج3، ص386.
[1093] اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج5، ص317.
[1094]الخوارزمي، محمد بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص237.
[1095] المصدر السابق: ج2، ص109ـ 110.
[1096]الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص323.
[1097] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج23، ص273.
[1098]اُنظر: الآجري، محمد بن الحسين، الشريعة: ج5، ص2174ـ 2175.
[1099] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج12، ص376.
[1100] اُنظر: ابن عبد البرّ، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج4، ص1921.
[1101]اُنظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج2، ص210.
[1102] الحاكم النيسابوري، عبد الله، المستدرك: ج4، ص19. وقد رواها عن شهر، إسماعيل بن نشيط. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج2، ص371. وقد رواها عن شهر، أبو الجحاف داوُد بن أبي عوف، والسند في أقل حالاته حسن لغيره بضميمة الطريقين.
[1103] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج9، ص194. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص108.
[1104] الذهبي، محمد بن أحمد، مَن تُكلّم فيه وهو موثّق أو صالح الحديث (تحقيق الرحيلي): ص265ـ 266.
[1105] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد (تحقيق حمزة أحمد الزين): ج18، ص258.
[1106]الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج2، ص210.
[1107] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج3، ص211.
[1108] قطب الدين الراوندي، سعيد بن هبة الله، الخرائج والجرائح: ج3، ص1145ـ 1147. الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص694ـ 696. الصدوق، محمد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة: ص534.
[1109] اُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج13، ص70.