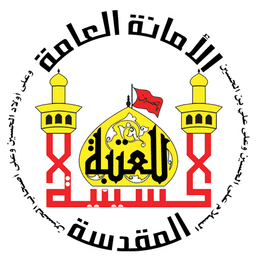مقدمة المؤسسة
إنّ تأسيس المراكز والمؤسسات العلمية من شأنه أن يثري الواقع العلمي والثقافي في أوساط المجتمع، وهو من أهم حلقات المعرفة ونشرها بالشكل الصحيح فيما إذا كان مبنياً على أسس واضحة ومنطقية.
من هنا أخذت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة على عاتقها إنشاء المؤسسات والمراكز العلمية والثقافية، وإيماناً منها بأنّ التخصص عامل مؤثر في تقييم الواقع ومحاكاته بشكل أدق، عمدت إلى إنشاء مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، وهي مؤسسة علمية متخصصة في دراسة النهضة الحسينية من جميع أبعادها التاريخية والفقهية والعقائدية والسياسية والاجتماعية والتربوية والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة المرتبطة بهذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكفّل بدراسة سائر ما يرتبط بالإمام الحسين× ومن كان معه في كربلاء، وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق هذه المؤسسة المباركة ـ كونها مختصة بأحد أهمّ القضايا الدينية، بل والإنسانية ـ فقد قامت بالعمل على مجموعة من المشاريع العلمية التخصصية التي من شأنها أن تعطي نقلة نوعية للتراث والفكر والثقافة الحسينية، منها:
1: قسم التحقيق، والعمل فيه جار على تحقيق موسوعة حول التراث المكتوب عن الإمام الحسين× ونهضته المباركة، سواء المقاتل منها أو التاريخ أو السيرة أو غيرها، وسواء التي كانت بكتاب مستقل أو ضمن كتاب. وكذا العمل جار في هذه الوحدة على متابعة المخطوطات الحسينية التي لم تطبع إلى الآن، لجمعها وتحقيقها، ثم طباعتها ونشرها.
2: قسم التأليف، والعمل فيه جار على تأليف كتب حول الموضوعات الحسينية المهمة التي لم يتم تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تعطَ حقّها من ذلك، كما ويتم استقبال الكتب الحسينية المؤلّفة خارج المؤسسة ومتابعتها علمياً وفنّياً من قبل اللجنة العلمية، وبعد إجراء التعديلات والإصلاحات اللازمة يتم طباعتها ونشرها.
3: مجلّة الإصلاح الحسيني، وهي مجلّة فصلية متخصصة في النهضة الحسينية، تهتم بنشر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النهضة المباركة وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية والاجتماعية والفقهية والأدبية في تلك النهضة المباركة.
4: قسم ردّ الشبهات عن النهضة الحسينية، ويتم فيه جمع الشبهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، ثم فرزها وتبويبها، ثم الرد عليها بشكل علمي تحقيقي.
5: الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×، وهي موسوعة تجمع كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ثم تبويبها حسب التخصصات العلمية ووضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علمية ممازجة بين كلمات الإمام× والواقع العلمي.
6: قسم دائرة معارف الإمام الحسين×، وهي موسوعة تشتمل على كل ما يرتبط بالنهضة الحسينية من أحداث ووقائع ومفاهيم ورؤى وأسماء أعلام وأماكن وكتب وغير ذلك من الأمور، مرتبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علمية رصينة تُراعى فيها كل شروط المقالة العلمية، ومكتوبة بلغة عصرية وبأُسلوب سلس.
7: قسم الرسائل الجامعية، والعمل فيه جار على إحصاء الرسائل الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصصة؛ لرفع النواقص العلمية وتهيئتها للطباعة والنشر. كما ويتم إعداد موضوعات حسينية تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طلاب الدراسات العليا.
8: قسم الترجمة، والعمل فيه جار على ترجمة التراث الحسيني باللغات الأخرى إلى اللغة العربية.
9: قسم الرصد، ويتم فيه رصد جميع القضايا الحسينية المطروحة في الفضائيات والمواقع الالكترونية والكتب والمجلات والنشريات وغيرها، مما يعطي رؤية واضحة حول أهم الأمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامة للمؤسسة، ورفد بقية الأقسام فيها وكذا بقية المؤسسات والمراكز العلمية بمختلف المعلومات.
10: قسم الندوات، ويتم من خلاله إقامة ندوات علمية تخصصية في النهضة الحسينية، يحضرها الباحثون والمحققون وذوو الاختصاص.
11: قسم المكتبة الحسينية التخصصية، حيث قامت المؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية تخصصية تجمع التراث الحسيني المطبوع.
وهناك مشاريع أُخرى سيتم العمل عليها قريباً إن شاء الله تعالى.
كتاب الأُطر الشرعية والقانونية لثورة الإمام الحسين×
جاء هذا الكتاب ضمن أحد مشاريع المؤسسة؛ إذ وقع على عاتق قسم التأليف الكتابة في المواضيع الحسينية ذات الأهمية البالغة، فوقع الاختيار في باكورة عمل هذا القسم على عدّة مواضيع، كان من بينها موضوع الأُطر الشرعية والقانونية لثورة الإمام الحسين×، وكان الهدف منه تسليط الضوء على الثورة المباركة من وجهة نظر شرعية دينية، وهل أنّها ثورة معتمدة ومرتكزة في انطلاقتها على أُسس شرعية واضحة وبينة، أم كانت ثورة يعزوها الدليل وتنقصها الحجّة؟
وكذلك تسليط الضوء على هذه الثورة من وجهة نظر قانونية وضعية، وأنه وفقاً للقانون الوضعي هل تعتبر هذه الثورة مشروعة أم تعتبر تمرّداً مخالفاً للقانون؟
وقد استطاع الدكتور الشيخ حكمت الرحمة ـ مؤلف الكتاب ـ أن يعطي صورة واضحة مدلّلة عن هذا الموضوع المهم والحيوي من خلال سبر الأدلة الشرعية والقوانين الوضعية، وتحليل الواقعة وظروفها وشروطها تحليلاً دقيقاً، فنأمل أن يكون هذا الكتاب محطّ أنظار أهل التحقيق والتدقيق على المستوىين الحوزوي والأكاديمي كون المؤلف قد جمع في دراسته هذه بين هذين المستويين.
وفي الختام نتمنّى للمؤلف ولجميع الأخوة في وحدة التأليف دوام الموفقية والسداد لخدمة القضية الحسينية.
نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنه سميع مجيب.
اللجنة العلمية في
مؤسسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحيّ القيوم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
منذ تلك اللحظة التي انطلقت فيها صرخة الإمام الحسين× في كربلاء، والأُمّة بطبقاتها المختلفة، بصغارها وكبارها، برجالها ونسائها، تنهل من هذه الثورة، وتتأمّل في فصولها، وتعيش حوادثها، وتستقرئ تلك الوقفات، فتعيش العَبرة تارة، وتستلهم العِبرة تارةً أُخرى، فعاشوراء أضحت مدرسة تمدّ الدنيا بأنواع العطاء، فهي تُجسّد كلّ المبادئ والقيم، وتدعو الإنسان ليعيش إنساناً حرّاً كريماً كما خلقه الله سبحانه، فهي ثورة ضدّ التسلّط وضدّ العبودية، وضدّ كلّ أنواع التجبّر، ثورة رخصت فيها الدماء في قبال تحطيم قيود الذلّ والأسر التي كبّلت أيادي الناس، ثورة جعلت من الإصلاح شعاراً صريحاً وواضحاً لانطلاقتها، فتفانى فيها الكبير والصغير، والطفل والمرأة؛ لتقدّم لكلّ الفئات، لكلّ الأجيال، لكلّ الطبقات، تعلّم الأُمّة معنى التفاني في سبيل الدين والعقيدة، معنى الوقوف بين يدي الله في لحظات تتهاوى فيها سهام الأعداء يميناً شمالاً، إنّها ثورة إحياء لدين أُريدَ له أن يُقبر، ولعقائد أُريدَ لها أنْ تُبدّل ولأحكام طُمست أو ما زالت تُطمس...
ومع هذا الوضوح في شعار الثورة، ومع وضوح الانحراف في واقع تلك الأمّة، ومع معرفة الجميع بقائد الثورة وربّان سفينتها، مع وضوح هذه الأُمور الثلاثة، فإنّ هناك أقلاماً قديماً وحاضراً، ولربّما مستقبلاً تحاول النيل من هذه الثورة المباركة، بحجج ومسوّغات مختلفة، وفق رؤى وأفكار بحاجة إلى مناقشة وبيان من الأساس، وطبيعي فإنّ الإصرار على بثّ هذه الشبه وكثرة ترديدها، خصوصاً ونحن في عالم الإنترنت والقنوات الفضائية قد تثير الشكوك عند هذا وذاك، مع ملاحظة أنّ رواد الإنترنت ومشاهدي الفضائيات يحملون مستويات ثقافية مختلفة.
لذا حاولنا في هذا الكتاب أنْ نسلّط الضوء على مشـروعية الثورة من المنطلقين الشرعي والقانوني، بمعنى أنْ نستقرئ أحداث تلك الفترة، ونرى ما يقتضيه الموقف من وجهةٍ شرعية، وكذلك نحاول الإشارة إلى الموقف وفق رؤى القانون الوضعي المعمول به في هذه الأزمنة، مقتصـرين في ذلك على القوانين المتسالمة، المعمول والملتَزم بها عند الكثير من الدول؛ لنرى ما تملكه هذه الثورة من رصيدٍ شرعيّ، وإطارٍ قانوني تتقوّم بهما مشروعيتها.
وقد جاء البحث في ستّة فصول، تناول الأول عدّة من المباحث التمهيدية:
دار الأول منها حول ضرورة الإمامة، مع نظرة موجزة في شرعية إمامة أهل البيت^ على ضوء القرآن والسنة.
وتناول الثاني تعريف القانون الوضعي، وبيان أهمّيته في تنظيم حياة الفرد والمجتمع.
وتركّز الثالث حول بيان مفهوم الثورة ومعالمها.
وأمّا الفصل الثاني، فقد حمل عنوان: مشروعية الثورة في ضوء صلح الإمام الحسن×، وفيه عدّة مباحث:
المبحث الأوّل: وفاة النبيّ’ وتغيير مسار الأُمّة.
المبحث الثاني: قراءة في شروط الصلح.
المبحث الثالث: مشـروعية عقد المعاهدة بين طرفين، شرعي وآخر غير شرعي.
المبحث الرابع: معاوية وإخلاله بشروط الصلح.
المبحث الخامس: الأثر المترتّب على مخالفة الهدنة شرعاً وقانوناً.
وحمل الفصل الثالث عنوان: مشـروعية الثورة في ضوء عدم مشـروعية الحاكم، وقد تناول أربعة مباحث أساسيّة:
المبحث الأول: صفات الحاكم وشروطه في الإسلام (نظرة مختصرة).
المبحث الثاني: يزيد وعدم أهليّته للخلافة.
المبحث الثالث: ولاية العهد من جهةٍ شرعية.
المبحث الرابع: بيعة يزيد من جهةٍ شرعية.
المبحث الخامس: مشروعية حكم يزيد في ضوء القوانين الوضعية.
وأمّا الفصل الرابع، فقد جاء بعنوان: مشـروعية الثورة في ضوء وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشـرعي، وضمان الحريات في القانون الوضعي، وقد تناول مبحثين:
المبحث الأوّل: الثورة الحسينية وفق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفاظ على بيضة الإسلام.
المبحث الثاني: الحريّة ورفض الظلم والاستعباد وفق القانون الوضعي.
وأمّا الفصل الخامس فهو: مشروعية الثورة وفق بيعة المجتمع الإسلامي للإمام الحسين×، وقد تضمّن مبحثين:
المبحث الأول: مؤهّلات الإمام الحسين× للخلافة.
المبحث الثاني: رسائل أهل الكوفة والبصرة، وانعقاد البيعة للحسين×.
وحمل الفصل السادس عنوان: دلائل قرآنية ونبوية على مشـروعية ثورة الإمام الحسين×، تناولنا فيه بعض الأدلّة التي يُستفاد منها مشـروعية الثورة وحقّانيتها، بغضّ النظر عن معرفتنا بظروفها وأجوائها، وتضمّن هذا الفصل مبحثين:
المبحث الأوّل: الثورة الحسينية وفق نظرية النصّ.
المبحث الثاني: النصوص الدالّة على فضائله والتي يمكن من خلالها الحكم على مشروعية الثورة.
هذا، ونأمل أنْ نكون في عملنا هذا قد أوضحنا جانباً من الحقيقة، ورفدنا المكتبة الحسينية بنتاج يخدم الثورة ويصبّ في أهدافها، فإنْ تمّ ما أردنا فللّه الحمد والمنّة على توفيقه، وإنْ كانت الأُخرى فهو من القصور الذي لا يسلم منه غير المعصوم، وأملنا كبير بطلاب العلم أنْ يتحفونا بكلّ ما من شأنه أن يُوصل العمل إلى مبتغاه في لاحق الإيام، إنْ كتب الله لنا الحياة والدوام.
وأخيراً نحمد الله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، ونصلّي ونسلّم على الحبيب المصطفى محمّد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
حكمت الرحمة
الفصل الأول
المبحث الأول
ضرورة الإمامة
ونظرة موجزة في شرعية إمامة أهل البيت ^
على ضوء القرآن والسنة
لعلّ من نافلة القول أنْ نتكلّم عن ضرورة وجود الإمام في كلّ مجتمع من مجتمعات البشرية، مع غضّ النظر ـ ابتداءً ـ عن المميزات والشؤون التي لا بدّ أنْ تتوفّر عند ذلك الإمام، بحسب ظرف ونوع ذلك المجتمع.
فالناظر لأي مجتمعٍ كان، يرى من الضرورة بمكان حاجته إلى قائد وحاكم تكون له المرجعية في إدارة شؤون الدولة وتنظيم علاقاتها، ويكون هو الموجِّه والمربِّي، وإليه ترجع الكلمة عند الخلاف والاختلاف، ولولا وجود الحكّام والقوانين لتحوّلت المجتمعات كافّة إلى غابة يفترس فيها القويُّ الضعيفَ، وتضيع فيها الحقوق، ويضطرب أمر الناس، ويلزم الهرج والمرج.
والمجتمع الإسلامي ليس بِدعاً من المجتمعات البشرية، بل زادته ميزة أنّه مجتمع يحمل رسالة ربّانية، تعدّ خاتمة الرسالات، فأضفت على قوانينه صبغة وحيانية، مُستمَدّة من القرآن والسنّة النبويّة، وكان النبيّ محمّد’ هو القائد السياسي، وهو القائد الروحي لذلك المجتمع، فحمل رسالة السماء، وتكفّل ببيانها وتبليغها، وتحمّل كافّة أنواع الأذى في سبيل ربط الإنسان بربّه، وهدايته إلى دينه، وتربيته وفق أُطر ومقرّرات السماء، فأدّى ما أُوكل إليه، فقاد الأُمّة على كافّة المستويات والصُعد، وكانت إليه المرجعية في جميع جوانب الحياة، فبالإضافة لقيادته السياسية للأُمّة كان مبيّناً لأحكام الشـريعة، وموضّحاً لعقائدها، ومفسراً للقرآن، ومربيّاً وهادياً للأُمّة، ومنتصفاً للمظلوم من الظالم، ومُقيماً للحدود والتعزيرات، وما إلى ذلك من أُمور تتعلّق بقيادة المجتمع، على المستويين السياسي والروحي.
وحيث إنّ هذه الرسالة هي الخاتمة؛ فلا بدّ من وجود خليفة للنبيّ’، له القدرة على إكمال وظائفه، من سياسة الأُمّة، وتدبير شؤونها، وبيان الأحكام، وتفسير القرآن، وإيضاح العقائد، وهداية الأُمّة لما فيه الخير والصلاح، وغير ذلك، خصوصاً إذا ما عرفنا أنّ الفترة التي قضاها النبيّ’ ـ مع ما بها من ملابسات وحروب ـ لم تُتِح له أنْ يبيّن جميع ما وصله من السماء، بالأخصّ عند ملاحظة أنّ الكثير من الأحكام لم تكن محلّ ابتلاء، ولم يتحقّق موضوعها خارجاً حتّى يبلِّغه النبيّ للناس، كما أنّه لم يفسـّر القرآن بشكلٍ كامل؛ لكونه باللغة التي نزل بها على قومه، فكانوا يفهمون القرآن باعتبارهم فصحاء العرب، سوى ما كان فيه من متشابهٍ أو مجمل، أو تبيين ناسخٍ، أو تفصيل مطلقٍ، وغير ذلك ممّا كانوا يرجعون فيه إلى النبيّ’ ويبيّنه لهم؛ ولذا فمن الضرورة لأجل بيان جميع الأحكام الواقعية إلى المجتمع الإسلامي، وبيان المراد من آي الذكر الحكيم، والحفاظ على الشـريعة الإسلامية، وإقامة حدودها في الأرض، كان لا بدّ من شخصٍ أمين، يكون محلاً لحفظ علم النبيّ وما تلّقاه من الوحي، ويقوم بوظائفه، ويكمل مسيرته؛ لذا فإنّ الشيعة الإمامية تعتقد بأنّ منصب الإمامة هو إكمال لمنصب النبوة، وكما أنّ النبوة تنصيب من الله سبحانه وتعالى، ولا دخل للبشر في تعيينها، فكذلك الإمامة فهي تنصيب من الله، وبيانٌ من الرسول لذلك.
من هنا؛ اختلفت نظرية الإمامية في طريقة تعيين الإمام والخليفة، واختلفت عن غيرهم في شؤون ووظائف الإمام، فهي لا ترى أنّ الإمام حاكماً سياسيّاً فقط، حتى يُوكل أمره إلى الناس، بل ترى ـ كما أشرنا ـ إلى قيامه بوظائف النبيّ’؛ لذا فهي تعتقد بوجوب أنْ يكون الإمام منصوباً من السماء؛ ليتسنّى له القيام بوظائفه بصورة صحيحة وكاملة، فذهبت ـ طبقاً لذلك ـ إلى نظرية النصّ (أي أنّ الإمام لا بدّ أنْ يكون منصوصاً عليه في القرآن والسنّة)، وأوضحت أنّ الواقع الخارجي ـ من خلال استقراء النصوص الدينية ـ قد دلّ على ذلك أيضاً، فهي ترى أنّ هناك نصوصاً عديدة دلّت على تعيين الإمام، وتعتقد طبقاً للنصوص بأنّ الأئمة إثنا عشـر، أوّلهم الإمام علي بن أبي طالب×، وآخرهم الإمام المهدي المنتظر#.
وقد وردت هذه النصوص على عدّة أنحاء، تكفّل بعضها ببيان أنّ الخليفة بعد النبيّ’ هو الإمام علي×، وتكفّل الآخر بأنّ الأئمّة من عترة النبي’، وتكفّل نحوٌ ثالث ببيان أنّ عدد الأئمّة اثنا عشر، وهم من قريش حصـراً. نشير فيما يلي مجملاً إلى بعض هذه النصوص:
1ـ آية الولاية: وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) [1].
والاستدلال بهذه الآية يتوقّف على أمرين:
الأوّل: إنّ المراد من الذين آمنوا في الآية هو علي بن أبي طالب×.
والثاني: إنّ المراد بالولاية هي الأولوية في التصرّف، الثابتة للنبيّ’ بقوله تعالى:
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[2].
أمّا الأوّل: فهو ممَّا استفاضت به الروايات، وبه قال بعض الصحابة والتابعين، وعلماء التفسير والحديث، فقد ذهب ابن عباس، والسدي، وعتبة بن حكيم، وثابت بن عبد الله إلى أنّ الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب×؛ إذ مرّ به سائل وهو راكع في المسجد وأعطاه خاتمه[3]، وبه قال مقاتل ومجاهد[4]، وقال الآلوسي: «وغالب الأخباريين على أنّها نزلت في علي (كرّم الله تعالى وجهه)[5]. وقال في موضعٍٍ آخر: «والآية عند معظم المحدّثين نزلت في عليّ (كرّم الله تعالى وجهه)[6].
وقد ذكر السيوطي عدّة من الروايات تدلّ على ما ذكرنا، وأنّ الآية نازلة في علي بن أبي طالب×، تنتهي إلى عمّار وعلي وابن عبّاس بطريقين، ومجاهد وسلمة بن كهيل، ثمّ قال: «فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضاً[7].
على أنّ هناك روايات أُخرى تنتهي إلى عددٍ آخر من الصحابة، منهم: جابر بن عبد الله الأنصاري[8]، وأبو ذر الغفاري[9]، وأنس بن مالك[10]، وعبد الله بن سلام[11] ، كما ورد عن الصحابي حسّان بن ثابت، عدّة أبيات شعرية في هذه المناسبة، قال:
|
أبا حسنٍ تفديك نفـسي ومهجتي |
وكلّ بطيء في الهدى ومسارع |
|
أيذهب مدحي والمحبر ضائعاً |
وما المدح في جنب الإله بضائع |
|
وأنتَ الذي أعطيت إذ كنت راكعاً |
زكاةً فدتك النفس يا خير راكع |
|
فأنزل فيك الله خير ولايةٍ |
فبيَّنها في نيّرات الشـرائع[12] |
وهناك روايات غير ما أشرنا إليها تنتهي إلى عددٍ آخر من التابعين، منهم: محمد بن الحنفية، وعطاء بن السائب، وعبد الملك بن جريج[13]، وغيرهم.
هذا، وقد وقع جدل وكلام حول صحّة هذه الروايات، فقال بعض أهل السنّة: إنّ هذه الروايات غير صحيحة، بل أكثرها شديدة الضعف لا يمكن أنْ تتعاضد فيما بينها، فلا يثبت نزول الآية في علي×.
ونحن في هذا الاختصار لا يمكن أنْ ندرس جميع هذه الروايات، ولكن نشير مجملاً إلى أمرين:
أولاً: إنّ التحقيق يقتضي صحّة بعض هذه الروايات، ولا نسلّم بضعف جميعها، فضلاً عن شدّة ضعفها، وقد تمّ دراسة بعض أسانيد هذه الروايات في كتاب: (نقد كتاب أُصول مذهب الشيعة) فليُراجع[14].
ثانياً: إنّ كون الروايات الشديدة الضعف لا تتعاضد مع بعضها مطلقاً، هي مسألة غير مسلّمة عند أهل السنّة، فقد ذهب ابن حجر، وكذا السيوطي إلى خلاف ذلك، قال السيوطي: «وأمّا الضعيف لفسق الراوي أو كذبه، فلا يؤثّر فيه موافقة غيره له، إذا كان الآخر مثله؛ لقوّة الضعف وتقاعد هذا الجابر، نعم، يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً، أو لا أصل له، صرّح به شيخ الإسلام، قال: بل ربّما كثرت الطرق حتّى أوصلته إلى درجة المستور السيّء الحفظ، بحيث إذا وُجِد له طريقٌ آخر فيه ضعف قريب محتمل؛ ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن[15].
وتبعهم على ذلك القاسمي في قواعده[16]، وإليه مال السخاوي[17].
وإذا ما عرفنا أنّ طريق سلمة بن كهيل، هو طريقٌ صحيح، وإنّ تمام علّته هو الوقف على التابعيّ، وبضميمة أنّ الموقوف على التابعي إذا كان في أمرٍ غيبي غير قابل للإجتهاد ولا يُقال بالرأي؛ فهو بحكم المرفوع إلى النبي’، لكنّه مرفوعٌ مُرسَل، فيكون الضعف في هذا الحديث ضعفاً خفيفاً للإرسال، بالطبع مع التنزّل عن القول بحجيّة المُرسَل، وهو مذهب طائفة كبيرة.
والضعف الخفيف يزول بمجيئه من وجهٍ آخر، فهذا الطريق بإضافته إلى سائر الطرق الأخرى ـ على فرض التسليم بشدّة ضعفها ـ يرفع المجموع إلى الحسن لغيره، وهو حجّة عند جماهير العلماء.
أمّا الثاني: فإنّ الآية الكريمة تدلّ على أنّ المراد من الولاية هي الأولويّة في التصرّف، ولا يمكن أنْ يراد منها النصرة؛ ذلك أنّها تحصر الولاية بموجب أداة الحصر (إنّما) في ثلاثة، الله ورسوله والذين آمنوا، فولاية الرسول وكذلك الذين آمنوا متفرعة وتابعة لولاية الله، وولايته ولاية عامّة، ولا يمكن تقييدها وحصرها بالنصرة، فكذلك ولاية الرسول، وولاية الذين آمنوا.
وأيضاً، فإنّ حصر الولاية بالله ورسوله والذين آمنوا بالشـروط المذكورة، والتي منها إعطاء الزكاة وهم في حال الركوع، لا يمكن تفسيرها بالنصـرة؛ لأنّ النصرة غير مختصّة بأحد، بل شاملة لجميع المؤمنين، وهو ما يدلّ عليه قوله تعالى:
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) [18]، أي: بعضهم ناصرٌ لبعض، فلا بدّ أنْ يكون المراد من الولي هو مَن له أولوية في التصرّف في شؤون الأُمّة، وهو ما تقوله الشيعة من أنّ الآية تُثبت إمامة عليٍّ×، وإلّا يكون القيد في الآية لغواً لا معنى له، واللغو لا يصدر من الحكيم سبحانه وتعالى.
هذا وهناك شبهات أُثيرت حول هذه الآية ودلالتها على المطلوب، وقد تكفّلت الكثير من الكتب بمناقشتها، والجواب عنها، فليراجع[19].
2ـ حديث الغدير المعروف: وهو قوله’: «مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه.
وهو حديثٌ صحيح، ومتنه الذي ذكرناه متواتر. رواه الجمّ الغفير، عن الجمِّ الغفير، وأخرجه كبار العلماء والحفّاظ في مصنّفاتهم، ونحن نقتصـر هنا على ذكر طريق واحد؛ توخياً للاختصار، فعن أبي الطفيل، قال: «جمع علي (رضي الله تعالى عنه) الناس في الرحبة، ثمّ قال لهم: أُنشد الله كلّ امرئٍ مسلمٍ سمع رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، يقول يوم غديرخم ما سمع لما قام، فقام ثلاثون من الناس ـ وفي روايةٍ: فقام ناسٌ كثير ـ فشهدوا حين أخذ بيده، فقال للناس: أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: مَن كنت مولاه فهذا مولاه، اللّهم والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه. قال: [يعني الصحابي أبا الطفيل]، فخرجت وكأنّ في نفسـي شيئاً، فلقيت زيد بن أرقم، فقلت له: إنّي سمعت علياً (رضي الله عنه) يقول: كذا وكذا، قال: فما تُنكر، قد سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول ذلك له.
أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان[20]، قال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، غير فطر بن خليفة وهو ثقة[21]، وقال الألباني: «وإسناده صحيح على شرط البخاري[22].
والحديث رُوي بطرقٍ عديدة جدّاً، عن عددٍ كبير من الصحابة؛ لذا قال الذهبي معلّقاً على أحد الطرق: «هذا حديثٌ حسن عالٍ جداً، ومتنه فمتواتر[23].
وقال عند ترجمته للطبري: «قلت: جمع طرق حديث غدير خمّ في أربعة أجزاء، رأيت شطره، فبهرني سعة رواياته، وجزمت بوقوع ذلك[24].
وقال ابن حجر: «وأمّا حديث: (مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه)، فقد أخرجه الترمذي والنسائي، وهو كثير الطرق جدّاً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتابٍ مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان[25].
وقال الألباني: «وجملة القول: إنّ حديث الترجمة [مَن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه] حديثٌ صحيح بشطريه، بل الأول منه متواتر عنه (صلّى الله عليه وسلّم)، كما يظهر لمَن تتبّع أسانيده وطرقه، وما ذكرت منها كفاية[26].
هذا من حيث السند، وأمّا من حيث الدلالة، فالشواهد والقرائن تؤكّد بما لا يقبل الشك أنّ المراد من الولاية من الحديث هو الأولوية في التصرف في شؤون الأُمّة، وليست من المحبّة أو النصـرة في شيء، ومن جملة تلك القرائن أنّ النبيّ’ أشهد الناس على ولايته عليهم بقوله: أتعلمون أنّي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ثمّ فرّع على هذه الولاية الثابتة له’، والتي هي الأولوية في التصـرف، كما جاء القرآن: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)[27]، فرّع عليها ولاية الإمام عليّ×، فلا بدّ أنْ يكون المراد واحد، وأنّ نفس ولاية النبي قد انتقلت لعلي×، كما أنّ استشهاد الإمام علي× بالحديث، وأخذه إقرار الناس بأنّ النبي’ قد قال الحديث فيه، يحمل نفس المعنى السابق، بل خروج أبي الطفيل وفي نفسه شيء لا يتماشى مع إرادة النصرة الثابتة لكلّ المؤمنين، بل يتماشى مع كونها ولاية عامّة على المؤمنين، كما أنّ ورود حديث الغدير في بعض طرقه مع حديث الثقلين الآتي ذكره، والدال على وجوب التمسّك بأهل البيت^، يحمل نفس تلك الدلالات، وغير ذلك من القرائن العديدة، التي لا يمكن معها حمل الولاية على مجرّد النصرة أو المحبّة.
3ـ حديث الثقلين: وهو أحد النصوص الصحيحة الدالّة على مرجعية أهل البيت^ ووجوب الرجوع إليهم، فقد أخرج مسلم في صحيحه، عن زيد بن أرقم، قال: «أمّا بعد، ألا أيّها الناس، فإنّما أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسول ربّى فأُجيب، وأنا تاركٌ فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به... وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي[28].
وأخرجه إسحاق بن راهويه، كما ذكره ابن حجر والبوصيري، بسنده إلى علي بن أبي طالب×: «إنّ النبي (صلّى الله عليه وسلّم) حضـر الشجرة بخم، ثمّ خرج آخذاً بيده علي، فقال: ألستم تشهدون أنّ الله ربّكم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تشهدون أنّ الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم، وأنّ الله ورسوله مولاكم؟ قالوا: بلى. قال: فمَن كان الله ورسوله مولاه فإنّ هذا مولاه، وقد تركتُ فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا، كتاب الله سببه بيده وسببه بأيديكم، وأهل بيتي. قال البوصيري بعد ذكره للحديث: «رواه إسحاق بسندٍ صحيح...[29].
وقال ابن حجر: «هذا إسنادٌ صحيح[30].
وأخرج النسائي بسنده إلى زيد بن أرقم أيضاً، قال: «لّما رجع رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) عن حجّة الوداع ونزل غدير خم، أمرّ بدوحات فقممن، ثمّ قال: كأنّي قد دُعيتُ فأجبت، إنّي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنّهما لن يتفرّقا حتى يردا عليّ الحوض. ثمّ قال: إنّ الله مولاي، وأنا وليّ كلّ مؤمن، ثمّ أخذ بيد عليّ، فقال: مَن كنت وليّه، فهذا وليّه، اللهم والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه. فقلت لزيد: سمعتَه من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال ما كان في الدوحات رجل إلّا رآه بعينه وسمع بأذنه[31].
وأورده ابن كثير، وتعقّبه قائلاً: «قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديثٌ صحيح[32].
والحديث له طرق عديدة جدّاً، وصحّحه عدّة من العلماء، بل لا يبعد القول بتواتره، قال أبو منذر سامي بن أنور المصري الشافعي: «فحديث العترة، بعد ثبوته من أكثر من ثلاثين طريقاً، وعن سبعة من صحابة سيّدنا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ورضي عنهم، وصحّته التي لا مجال للشكّ فيها، يمكننا أن نقول: إنّه بلغ حدّ التواتر[33].
وأمّا دلالته، فهو صريح في وجوب الأخذ من أهل البيت^ واقتفاء أثرهم، وأنّ الاستقامة على جادّة الشريعة وعدم الضلال موقوفٌ على التمسّك بهم، قال الملّا علي القاري: «والمراد بالأخذ بهم التمسّك بمحبّتهم، ومحافظة حرمتهم، والعمل بروايتهم، والاعتماد على مقالتهم...[34].
ومن خلال دلالته على وجوب التمسّك بهم مطلقاً، وأنّ عدم الضلال منوطٌ بذلك؛ يتّضح أنّ الحديث يدلّ على عصمتهم، وعدم مفارقتهم للشـريعة في كلّ أفعالهم وأقوالهم، خصوصاً أنّه قرنهم بالقرآن، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا على النبيّ الحوض في يوم القيامة، والقرآن معصوم من الخطأ، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فكذلك أهل البيت^، وإلّا وقع الافتراق.
4ـ حديث الاثني عشر خليفة: وهذا الحديث ممّا اتفق الفريقان على صحّته، وهو يدل على أنّ عدد خلفاء النبي اثنا عشر خليفة فقط، فقد أخرج مسلم، بسنده عن حصين، عن جابر بن سمرة، قال: «دخلت مع أبي على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فسمعته يقول: إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال: ثمّ تكلّم بكلامٍ خفي عليّ، قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلّهم من قريش[35].
وأخرج بسنده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال: «كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيءٍ سمعته من رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم). قال: فكتب إليَّ سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يوم الجمعة عشية رجم الأسلمي يقول: لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم اثنا عشـر خليفة كلّهم من قريش[36].
وأخرج البخاري بسنده إلى جابر بن سمرة، قال: «سمعت النبي (صلّى الله عليه وسلّم) يقول: يكون اثنا عشر أميراً. فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنّه قال: كلّهم من قريش[37].
وأخرج أحمد بسنده إلى مسروق، قال: «كنّا جلوساً عند عبد الله بن مسعود، وهو يُقرئنا القرآن، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، هل سألتم رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) كم تملك هذه الأُمّة من خليفة؟ فقال عبد الله بن مسعود: ما سألني عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك. ثمّ قال: نعم، ولقد سألنا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، فقال: اثنا عشر، كعدّة نقباء بني إسرائيل[38].
والحديث بلفظ مسروق حسّن سنده ابن حجر[39]، والبوصيري[40]، وغيرهم.
وقال أحمد محمّد شاكر: «إسناده صحيح[41].
فالحديث صحيحٌ بلا كلام، خصوصاً بعد اتّفاق الشيخين على روايته، ودلالته على أنّ خلفاء النبي اثنا عشر خليفة جلية ظاهرة للعيان، وهذا العدد كما هو واضح ينطبق على ما تذهب إليه الشيعة الإمامية الاثنا عشـرية، من وجود الاثني عشر إماماً من أهل البيت^، أولهم علي×، وآخرهم المهدي#.
أمّا أهل السنّة، فبقوا في حيرة من أمر هذا الحديث، ولم يجدوا له مخرجاً؛ لأنّهم إنْ قالوا هم الخلفاء الأربعة نقص عددهم، وإن أدخلوا فيهم الخلفاء الأُمويين، أو العباسيين زاد عددهم؛ لذا راحوا ينتقون انتقاء حسب أهوائهم، وكأنّ الرسول الأكرم’ ترك هذا الأمر المهم الخطير في مهبّ الريح.
الخلاصة:
وخلاصة ما ننتهي إليه من هذا المبحث أنّ خلفاء النبيّ’ اثنا عشر خليفة بحسب حديث الاثني عشر، وأنّهم من أهل البيت^ بحسب حديث الثقلين، وأنّ أولّهم عليّ بن أبي طالب× بحسب حديث الغدير وآية الولاية... وما ذكرناه كان نماذج من النصوص الدالّة على إمامة أهل البيت^ ليس إلّا، وليُطلب التفصيل من الكتب المعدّة لذلك.
القانون الوضعي وضرورته الاجتماعية
انتهينا في المبحث الأوّل إلى ضرورة وجود حاكم على الأُمّة، وعرفنا أنّ السلطة التشريعية والتنفيذية في الأُمّة الإسلامية كانت بيد النبيّ’، وأنّ النبيّ’ لم يترك أمر هذه الأُمّة سُدى، بل ترك خلفه اثنا عشـر خليفة، أي أنّ القانون الذي كان يسود الأُمّة، والذي يُفترض أن يقود الأُمّة على طول تأريخها هو القانون الإسلامي.
إلاّ أنّه من المُؤسف أنّ المسلمين في غالب المناطق الإسلامية، وفي أغلب فتراتهم الزمنية، لم يتمسّكوا بدينهم، ولم يُحكّموه فيما يجري بينهم؛ كما أنّ من الطبيعي أنّ غير المؤمنين بالإسلام لا يحتكمون إليه من بابٍ أولى، كما أنّهم تخلّوا عن شرائعهم السماوية التي يؤمنون بها؛ لذا كان لا بدّ من مرجعية يعودون إليها في حل مشاكلهم، وتدبير أُمورهم، فقاموا بوضع ما أسموه بالقانون الوضعي، وهو يختلف من دولةٍ إلى أُخرى بحسب ما تقتضيه ظروف تلك الدولة، وإن كانت الكثير من الفقرات متشابهة في الكثير من الدول.
وقد أشرنا فيما سبق إلى أنّ أيّ مجتمع بشري بحاجة إلى قائد وحاكم يدبّر أُمورهم، ونفس الكلام يشير إليه أهل القانون هنا، فالإنسان بحسب طبيعته المدنية لا يمكن أنْ يعيش بعيداً عن أفراد جنسه، فإنّ العيش بصورة منفردة هي خرافة لا يستطيع العقل تصديقها والإيمان بها، كما أنّ الناس يختلفون في السلوكيات والقابليات والطموحات، فالأنانية مثلاً، وحبّ الاستئثار، وغيرها من الرؤى والتوجّهات المختلفة تصل في كثير من الأحيان إلى التقاطع في المصالح، وحصول النزاعات الكثيرة والمختلفة، والتي تؤدّي إلى اضطراب المجتمع وحصول الفوضى فيه؛ لذا كان لا بدّ من وجود قواعد قانونية ملزمة، تقوم بتنظيم المصالح، ومنع قيام النزاعات أو تسويتها في حال نشوبها، كما أنّه من الضرورة أنْ يعرف الإنسان الحدود التي يقف عندها، وإزاء ذلك لا بدّ من وجود جزاء يمكن من خلاله تطبيق تلك النُّظم والضوابط؛ ولذا فإنّ القانون يُعدّ ظاهرة اجتماعية لا بدّ منها، بمعنى أنّه إذا لم يوجد مجتمع فليس للقانون من وجود، وليس له معنى ولا فائدة[42].
فالقانون ضروري لتنظيم حياة المجتمعات والشعوب، وتنظيم العلاقات بين أفرادها، وبينهم وبين السلطة الحاكمة.
وكلمة القانون مأخوذة من اليونانية من كلمة (kanun): وهي تعني المسطرة، أو العصا المستقيمة.
وفي اللغة: هو مقياس كلّ شيء وطريقه[43].
وأمّا اصطلاحاً، فهو: «مجموعة من القواعد التي تُنظِّم الروابط الاجتماعية، وتتوفر على جزاء يكفل طاعتها واحترامها[44].
أو: «هو مجموعة القواعد التي تنظّم العيش في الجماعة، والتي يجب على الكافّة احترامها، احتراماً تكفله السلطة العامّة، بالقوة عند الضرورة[45].
أو: «هو مجموعة القواعد العامّة والمجرّدة، والتي تهدف إلى تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، والمُلزِمة والمقترنة بجزاء توقّعه السلطة العامّة، جبراً على مَن يخالفها[46].
وكلّ هذه التعاريف تصبّ في بوتقة واحدة، وتعني أنّ القانون هو: مجموعة من اللوائح والنُّظم، وضعها الإنسان من أجل تنظيم حياة الأفراد وعلاقاتهم المختلفة، على كافّة المستويات والصُّعد.
هذا، وقد يُطلق القانون على معنى آخر أخصّ، فيُراد به مجموعة القواعد المُلزمة التي تصدر من السلطة التشريعية، والتي تنظِّم لوناً معيّناً من الروابط القانونية[47].
هذا، وتلحق بعض الصفات بالقانون فتعطيه مدلولاً معيّناً، فحينما يُقال: القانون الوضعي، فإنّما يُراد به: «مجموعة القواعد المُلزمة، التي تُوضع سلفاً لتنظيم حياة الأفراد، في مجتمعٍ معيّن، في زمانٍ معيّن، في مكان معيّن[48].
والقانون الوضعي له فروع عدّة، كالقانون المدني، والقانون التجاري، والقانون الإداري، والقانون الجنائي.
فمثلاً: القانون المدني: يتكوّن من مجموعة من القواعد التي يخضع لها الأفراد في روابطهم، بصرف النظر عن مهنتهم.
والقانون التجاري: هو مجموعة القواعد التي تحكم مجموعة معيّنة من الأعمال، هي الأعمال التجارية، ويخضع لها طائفة من الأشخاص، هم التجار[49].
والقانون الجنائي: هو ذلك الجزء من أحكام القانون، الذي يحدّد الجريمة والعقوبة.
والقانون الإداري: هو ذلك الفرع من القانون، الذي يحكم علاقات الدولة بوصفها صاحبة السلطة والأمر والنهي بالأفراد[50].
كما أنّ هناك ما يصطلح عليه بالقانون الدولي، والتعريف التقليدي له، هو: «مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول، والكيانات الدولية الأخرى[51].
وقبل الانتهاء من التعريف كان لا بدّ من بيان مختصر للقاعدة القانونية التي وردت في التعاريف أعلاه، فإنّ هناك شروطاً تنطبق على القاعدة، لكي تكون قاعدة قانونية، وهي:
أوّلاً: أنْ تكون مجرّدة وعامّة، فالعمومية تعني: أنّ القاعدة القانونية تطبّق على جميع الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط تطبيقها، فهي تخاطب الجميع دون استثناء، وتُطبّق مبدأياً على كلّ الوقائع.
أمّا التجريد، فيعني أنّ القاعدة القانونية لم تنشأ لتتحدّث عن شخص بذاته، أو تعالج قضيّة بعينها، بل إنّها تتحدّث عن الأشخاص، والأحداث، والوقائع بصفاتها، لا بشخوصها وذواتها.
ثانياً: إنّها قاعدة اجتماعية، تستهدف تنظيم الروابط، أو العلاقات الاجتماعية بين الأفراد.
ثالثاً: إنّها قاعدة مُلزمة، تقترن بجزاء قانوني يفرض احترامها[52].
رأينا من الضرورة أنْ نطلّ في هذا المبحث إطلالة سريعة نقف فيها على مفهوم الثورة وحقيقتها، ويبدو من خلال المراجعة أنّ مصطلح الثورة لم يُستخدم في القرآن الكريم، ولا السنّة النبوية المباركة، بل ولا في أدبيات العصور الإسلامية الأُولى، والمصطلح الرائج آنذاك والذي اشتهر بين المسلمين هو مصطلح (الخروج) أو (القيام) وما شابه ذلك، أمّا الثورة بهذا اللفظ، فلم يكن لها نصيب وافر آنذاك.
لذا؛ لا نجد اصطلاح (الثورة) في أوّل تحرك إسلامي كبير من نوعه، المتمثّل باجتماع الكثير من الصحابة والتابعين، ومن مختلف أرجاء المجتمع الإسلامي، مطالبين بإسقاط الخليفة آنذاك (عثمان بن عفّان)، واستبداله بخليفة يحمل الأُمّة على العدل والإنصاف، وكما هو معلوم تاريخياً أنّ الأُمور تطوّرت وتفاقمت وانتهت بمقتل الخليفة.
كما أنّه لم نجد اصطلاح الثورة يُطلق على التحرّك الحسيني المبارك في سنة (61) للهجرة، مع أنّها حركة اهتزّ لها العالم بأسره.
كما لم يُطلق مصطلح الثورة على تحرّك عبد الله بن الزبير ومبايعة الناس له في مكّة، وتولّيه زمام الخلافة فعلياً في عدّة من مناطق الدولة الإسلامية، الأمر الذي أدّى إلى وقوع القتال بينه وبين جيوش الأُمويين، منذ عهد يزيد وحتى عهد عبد الملك، وانتهى الأمر بمقتل ابن الزبير.
كما أنّ تحرّك التوابين وقيامهم على الحكم الأُموي لم يُسمّ ثورة، وكذلك تحرّك أهل المدينة.. وهكذا في بقيّة التحركات الأُخرى، فإنّه لم يعبّر عنها سابقاً بالثورة.
فإنّ مصطلح (الثورة) هو مصطلح متأخّر أُطلق فيما بعد، ثمّ استُخدم وطُبّق على التحرّكات التي سبقته سنين طويلة.
نعم، استُخدم عند بعض المؤرخين في القرن الرابع الهجري كلمة (ثار)، فمثلاً القاضي النعمان المغربي (ت363هـ)، قال: «ولمّا ثار مدلج على زيادة الله، خرج أهل السجن وخرج أبو العباس فيمَن خرج...[53].
وقال: «فأمّا من ثار عليه وعلى الأئمّة من ولده من الوثّاب، وخرج عليهم من الخوارج...[54].
كما أنّ هذه الكلمة ـ أعني (ثار) ـ استُخدمت كثيراً لكن بمعناها اللغوي، لا بمعنى الخروج على السلطة، فمثلاً جاء في مسند أحمد: «ثمّ ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فمسحت بها وجهي، فوجدتها أبرد من الثلج، وأطيب ريحاً من المسك[55].
وفي صحيح البخاري: «قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعُ الله لنا، فرفع يديه وما نرى في السماء قزعة، فوالذي نفسي بيده، ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال...[56].
وفي سنن أبي داود: «إنّ اللجلاج أباه أخبره أنّه كان قاعداً يعتمل في السوق، فمرّت امرأة تحمل صبيّاً فثار الناس معها وثرتُ فيمَن ثار، فانتهيت إلى النبي (صلّى الله عليه وسلّم) وهو يقول: مَن أبو هذا معكِ؟ فسكتت، فقال شاب: حذوها، أنا أبوه يا رسول الله...[57].
وفي إرشاد المفيد: «فلمّا مرَ به في المسجد وهو مستخفٍ بأمره، مماكر بإظهار النوم في جملة النيام، ثار إليه فضربه على أُمّ رأسه بالسيف[58].
ونحن إذا ما رجعنا إلى معاجم اللغة لرأينا أنّ (ثار) تُستعمل في: الهياج، والغضب، والوثوب، والظهور، والسطوع، والبحث والاستقصاء، وغيرها.
جاء في لسان العرب في مادة (ثور): «ثارَ الشـيءُ ثَوْراً وثُؤوراً وثَوَراناً وتَثَوَّرَ: هاج... والثائر: الغضبان. ويُقال للغضبان أَهْيَجَ ما يكونُ: قد ثار ثائِرُه وفارَ فائِرُه إِذا غضب وهاج غضبه. وثارَ إِليه ثَوْراً وثُؤوراً وثَوَراناً: وثب. ويُقال: انْتَظِرْ حتى تسكن هذه الثَّوْرَةُ، وهي: الهَيْجُ. وثار الدُّخَانُ والغُبار وغيرهما يَثُور ثَوْراً وثُؤوراً وثَوَراناً: ظهر وسطع... وثار به الدم وثار به الناس، أي: وثبوا عليه. وثور البرك واستثارها، أي: أزعجها وأنهضها. وفي الحديث: فرأيت الماء يثور من بين أصابعه، أي: ينبع بقوّة وشدّة. والحديث الآخر: بل هي حُمّى تثور أو تفور. وثار القطا من مجثمه، وثار الجراد ثوراً وانثار: ظهر[59].
وفي المعجم الوسيط: «ثار ثوراناً وثوراً وثورة: هاج وانتشـر، يقال: ثار الدخان والغبار، وثار الدم بفلان، وثارت به الحصبة، وثار به الشـر والغضب، وثار الماء من بين كذا: نبع بقوة وشدة. وثار به الناس: وثبوا عليه، وأثارَه إثارةً وإثاراً: هيَّجه ونشـرَه. وفي التنزيل العزيز: (فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا)[60]، وأثارَ الأرضَ: حرثها للزراعة، وفي التنزيل العزيز: (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا) [61]. ويُقال: أثارَ الأمرَ: بحثَه واستقصاه. وفي الأثر: (أثيروا القرآن؛ فإنّ فيه خيرَ الأولين والآخرين)[62].
وجاء في المصباح المنير: «ثار الغبار يثور ثوراً وثؤوراً ـ على فعول ـ وثوراناً: هاج، ومنه قيل للفتنة: ثارت، وأثارها العدو، وثار الغضب: احتد، و(ثار) إلى الشـر: نهض، و(ثوّر) الشر (تثويرا)، و(أثاروا) الأرض: عمروها بالفلاحة والزراعة[63].
ومن المعنى اللغوي يتّضح أنّه مأخوذ في كلمة ثار: التحرّك بقوّةٍ وغضب وهياج، وهو الذي ينسجم نوعاً ما مع ما يسمّى ثورة لاحقاً.
وأمّا في الاصطلاح، فيبدو أنّه لا يوجد تحديد واضح لمفهوم الثورة، فقد عرفوها في المعجم الوسيط، بأنّها: «تغيير أساسي في الأوضاع السياسية والاجتماعية يقوم به الشعب في دولةٍ ما[64].
ويمكن أنْ نؤاخذ على هذا التعريف أنّه ناظر إلى نتيجة التحرّك، لا إلى التحرّك نفسه، فماذا لو حصل تحرّك ولم يحقّق نتائجه ولم ينتصر، بل قُمع مثلاً ـ كما حدث في الانتفاضة الشعبانية التي اجتاحت كلّ مدن العراق ـ ولم يحقّق نجاحاً، فعلى هذا التعريف لا تسمّى ثورة، ومثلها الكثير من التحرّكات التي لم تحضَ بالنجاح، فالتعريف يقصر الثورة على التحرّك الذي حقّق أغراضه، أمّا نفس التحرّك من دون الحصول على التغيير المنشود فلا يسمّى ثورة.
وأمّا (المعجم الفلسفي) لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، فعرَّف (الثورة) بأنّها: «نقطة تحوُّل في حياة المجتمع، لقلب النظام البالي وإحلال نظام تقدّمي جديد محلَّه. وهي بهذا تتميّز من الانقلاب الذي يتلخّص في نقل السلطة من يدٍ لأُخرى[65].
وهذا التعريف غير واضح المعالم أيضاً، فلم يتبيّن معنى نقطة التحوّل ومنشؤها، هل هو بالحراك الجماهيري المسلح، أوكيفما اتّفق؟ كما أنّ التعريف محدّد بقلب نظام بالي بنظام تقدّمي، فماذا لو كان العكس؟ هل يسمّى ذلك الحراك ثورة أو لا؟
وماذا لو فشل الحراك ولم يحدث التحوّل، هل هو ثورة أو لا؟ فعلى هذا التعريف يكون فقط التحوّل من النظام البالي إلى نظام تقدّمي جديد هو الثورة.
أمّا (المعجم الفلسفي) لجميل صليبا، فقد عرّف الثورة بأنّها: «تغيير جوهري في أوضاع المجتمع لا تُتّبع فيه طرق دستورية. والفرق بين الثورة وقلب نظام الحكم أنّ الثورة يقوم بها الشعب، على حين أنّ قلب نظام الحكم يقوم به بعض رجالات الدولة، وثمّة فرق آخر بين الأمرين، وهو أنّ هدف الثورة تغيير النظام السياسي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، وهدف الانقلاب هو مجرّد إعادة توزيع السلطة، بين هيئات الحكم المختلفة... والثورة مقابلة للتطور، فهي سريعة وهو بطيء، وهي تحوُّل مفاجئ وهو تبدُّل تدريجي[66].
وهذا التعريف أيضاً يمكن التوقّف فيه، فماذا يسمّى الحراك المسلّح أو السلمي إذا لم ينجح وكان مصيره الفشل، وماذا يسمّى التحرّك السلمي عبر التظاهر، كما في ثورة يناير المصرية، وقبلها الثورة التونسية، فقد يُطلق عليه أنّه تحرّك مع مراعاة الطرق الدستورية؛ لأنّ التظاهر السلمي حقٌّ كفله الدستور! ثمّ ماذا نسمّي الحراك الذي لم يتمّ فيه تغيير جوهري في أوضاع المجتمع؟! وكذلك التفريق بين الثورة والانقلاب ليس دقيقاً، فقد يُحدث الانقلاب تغييراً جذرياً في طريقة الحكم وشكل الدولة، وبالتالي إحداث تغيير جذري في أوضاع المجتمع المختلفة، كما أنّ هناك شيئاً يشوبه التناقض، وهو أنّه بعد أن عرّف الثورة بأنّها التغيير، عاد وجعل أحد الفروق بينها وبين الإنقلاب هو: أنّ الثورة تهدف إلى التغيير، بينما هدف الانقلاب هو إعادة توزيع السلطة... والنتيجة أنّ التعريف لا يُعطي صورة واضحة عن حقيقة مفهوم الثورة.
فتلخّص من مجموع التعاريف المتقدّمة أنّه لا يوجد تصوّر واضح بيِّن عن حقيقة الثورة ومفهومها، ولذا نرى الباحثة وفاء علي داود، تقول: إنّه «لميكن هناك تحديد علميواضح لمفهومالثورة،وكل مايمكن قوله هو أنّ هناك محاولاتٍيصعب أن ترقى إلى مستوى التعريف العلمي. فالكلمة دارجةٌفيالاستخدام اليومي،وحتى فيالكتابة التاريخية،أطلقت كتسمية على عدد كبير من الظواهر المختلفة فيشدتها،والتيتمتد من أيّتحرّك مسلّح ــ أو حتّىغير مسلح ــ ضدّ نظام ما،إلى التحركات التيتطرح إسقاط النظام واستبداله،الأمر الذييصعّب عملية تدقيق المصطلح[67].
ويقول الباحث محمّد سيد بركة: «إنّ التعريف الجامع المانع لمصطلح الثورة ـ على حدّ تعبير المناطقة ـ أمرٌ يكاد يكون مستحيلاً؛ بسبب تنوع الفهم للمصطلح، وتنوّع اقترابات المفكرين منه، كلٌّ حسب إيديولوجيته وحسب اختصاصه.
فنجد مَن يستخدمه للدلالة على تغييرات فجائية وجذرية، تتمّ في الظروف الاجتماعية والسياسية، أي عندما يتمّ تغيير حكم قائم، وتغيير النظام الاجتماعي والقانوني المصاحب له بصورة فجائية، وأحيانًا بصورة عنيفة.
كما يستخدم المصطلح للتعبير عن تغييرات جذرية في مجالات غير سياسية، كالعلم والفن والثقافة؛ لأنّ الثورة تعني التغيير، واستخدم مفهوم الثورة بالمعنى السياسي في أواخر القرون الوسطى، كما يستخدم في علم الاجتماع السياسي للإشارة إلى التأثيرات المتبادلة للتغييرات الجذرية والمفاجئة للظروف والأوضاع الاجتماعية والسياسية[68].
ويرى الباحثون بأنّ أول تعريف وُضع للثورة هو مع انطلاق الشـرارة الأُولى للثورة الفرنسية، كما يذكرون بأنّ إفلاطون من أوائل الفلاسفة الذين عنوا بدراسة التغيرات التييمكن أن تطرأ علىالبناء السياسي،أمّا (أرسطو) فكان سبّاقاً فى دراسته للثورات،حيث قدّم أول محاولة شاملة لدراسة الثورة،وأفرد لها حيزاًكبيراًمن مؤلّفه الشهير: (السياسة)، وقد قبل مبدأ وجود الدولة،وقال بأنّ الأفكار الخاطئة تؤديإلىالإحساس بعدم الرضا،وبالتاليحدوث انقلاب سياسي،قديعمل علىتغيير شكل الدولة بمايترتّب علىذلك من نتائج سياسية،أيإنّ الثورة ظاهرة سياسية تمثّل عملية أساسية لإحداث التغيير الذيقديؤدّيإلىاستبدال الجماعات الاجتماعية[69].
وما يهمّنا في البحث هو الوقوف على مفهوم الثورة، والتعرّف على حقيقتها، وفي هذا الصدد ومضافاً لما ذكرناه من تعاريف مختلفة، نذكر مجموعة أُخرى من التعاريف؛ علّنا نقف على معنى مشترك بينها، ونصل إلى نتيجة نخلص من خلالها إلى معنى الثورة:
1ـ تعريف موسوعة علم الاجتماع، حيث عرّفت الثورة بأنّها: «التغييرات الجذرية في البُنى المؤسّسية للمجتمع، تلك التغييرات التي تعمل على تبديل المجتمع ظاهرياً وجوهرياً، من نمطٍ سائد إلى نمطٍ جديد يتوافق مع مبادئ وقيم وإيديولوجية وأهداف الثورة، وقد تكون الثورة عنيفة دموية، كما قد تكون سلمية، وتكون فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية[70].
2ـ تعريف كرين برنتون، حيث عرّفها في كتابه: (تشـريح الثورة) بقوله: «إنّها عملية حركية دينامية، تتميّز بالانتقال من بنيان اجتماعي إلى بنيان اجتماعي آخر[71].
3ـ تعريف هاري ايكشتاين، حيث عرّفها في مقدّمته عن الحرب الداخلية بأنّها: «محاولات التغيير بالعنف أو التهديد باستخدامه ضدّ سياسات في الحكم، أو ضدّ حكّام، أو ضدّ منظّمة.
وهناك تعاريف أخرى لا يسع البحث لذكرها[72].
ومن خلال التأمّل في جميع التعاريف الاصطلاحية التي ذكرناها، نجد أنّها ركّزت على مسألة التغيير في أوضاع المجتمع، وبعضها أشار إلى أنّها محاولات للتغيير، وبالرجوع إلى ما ذكرناه من المعنى اللغوي لكلمة (ثار)، يمكن أن نحصل على نتيجة بأنّ الثورة كما أنّها تعني التغيير الجذري في واقع الأُمّة، فكذلك تشمل محاولات التغيير ذات الحراك الواضح والقوي، فقد عرفنا في اللغة أنّ من معاني كلمة (ثار) هو الوثوب، فثار به الناس: أي وثبوا عليه، فجمعاً بين ما ذكرته اللغة من معاني، وبين النظر العرفي لمصطلح الثورة، نخرج بنتيجة أنّ الثورة تشمل التغيير، بل ومحاولات التغيير خصوصاً إذا كانت ذات صدى مرتفع ومن شخصيات مهمّة، أو كانت بحراك جماهيري كبير؛ ذلك أنّ اصطلاح الثورة إنّما أخذ من الواقع الخارجي، فبعد أنْ كانت هناك حراكات وتظاهرات وتمرّدات وانقلابات، اصطُلح على بعض منها كلمة (الثورة)، وإذا ما رجعنا إلى الفهم العرفي مشفوعاً بكتب اللغة سنجد أنّ العرف يطلق الثورة على كلّ تحرك نحو التغيير، شريطة أن لا يكون هذا التحرّك مغموراً، ولا تأثير له ألبتّة.
أمّا إذا كان الحراك جماهيرياً، أو نخبوياً، خصوصاً إذا كان مشفوعاً بقيادة بارزة معروفة، فلا شكّ في إطلاق اسم الثورة عليه، ولذا تجد في العرف والتعامل الاجتماعي يقولون هذه الثورة فشلت، وهذه الثورة انتصـرت، فالثورة تُطلق على كلا الشقّين، التي استطاعت أنْ تحقّق أهدافها وتُجري التغيير المنشود، أم تلك التي نادت بالتغيير لكنّها قُمعت بسبب قوّة السلطة، فكلاهما ثورة، بل يمكن القول إنّ كليهما يحدثان تغييراً وتزلزلاً في السلطة، لكن بدرجات متفاوتة.
كما أنّنا نرى العرف يطلق اسم الثورة على تحرّك نخبة معيّنة من المجتمع، فيقولون مثلاً: ثورة الفلاحين، أو ثورة الزنوج، أو ثورة العمّال، وهكذا...
والخلاصة: كما أنّ الثورة تصدق على الحراك الجماهيري الذي يحقّق أهدافه، فكذلك تصدق على كلّ تحرك بارز وظاهر يطمح في التغيير، وينشد قلب الأوضاع الموجودة بأُخرى تنسجم مع قيم ومبادئ الثوار.
لا يمكن حصر الثورات في أسباب محدّدة، فكلّ ثورة لها خصائها التي تمتاز بها، ولثوارها دوافع معيّنة، فقد تكون الدوافع دينية إصلاحية، وقد تكون الدوافع دنيوية هدفها الاستيلاء على الحكم، وقد تكون الدوافع اقتصادية، وقد تكون الثورة بسبب عدم العدالة وتفشّي الظلم، وعدم إعطاء الحريات والاستئثار بالسلطة والمقدّرات لفئة قليلة، أو غير ذلك ممّا يسهم في تحرّك الناس وفورانهم، وخروجهم مطالبين بتغيير الواقع الحالي الذي يعيشونه، فالأسباب والدواعي للثورة عديدة متنوّعة، تدخل فيها عوامل عديدة.
غير أنّ المهم في الأمر أن نبيّن أنّ الثورة بحدّ ذاتها ليست مقدسة، وأنّ قداستها إنّما تنبثق من الدواعي التي انطلقت من أجلها، فإنْ كانت الدواعي دينية بما تتضمّنه من رفض الظلم، وإقامة العدل، وإعطاء الحريات، وغير ذلك من المفاهيم التي تندب وتدعو لها الديانات، خصوصاً الدين الإسلامي، فيمكن أن تكتسب تلك الثورة نوعاً من القداسة.
وإن كانت الأهداف دنيوية بحتة تهدف إلى استبدال نظامٍ بنظام قد يكون أفسد، فلا قيمة لهذه الثورة؛ لذا فلا معنى للجدل الدائر حول تسمية بعض التحرّكات أو غيرها بأنّه ثورة أو لا؟ فمجرد تسمية الحراك بكونه ثورة لا يكفي في إضفاء القداسة عليها، ولا يكفي في اكتسابها الشرعية، فقد تكون ثورة كبرى تهدف إلى القضاء على الإسلام مثلاً، فهل تكسب تلك الثورة الشرعية؛ كونها حراكاً جماهيرياً كبيراً مثلاً؟ فالذي نراه أنّ الخلاف يتأتّى فيما إذا كانت القداسة والقيمة الأخلاقية والمشروعيّة مرتبطة بالثورة بما هي، أمّا إذا كانت تلك القيم مرتبطة بالأهداف فالتسمية بالثورة من عدمه لا يغيّر من الواقع شيئاً.
هذا، وقد شهد العالم ـ بانتماءات جماهيره المختلفة ـ عدداً كبيراً من الثورات، فبعض الثورات كانت شعبية جماهيرية، كالثورة الفرنسية عام 1789م، وثورة أوربّا الشرقية عام 1989م ، أو تكون الثورة عبارة عن مقاومة ضدّ المحتل كالثورة الجزائرية، وغير ذلك من الثورات التي سادت وما زالت تسود العالم. والجدير بالتأمّل هنا هو أنّ الثورات المنطلقة ضدّ الظلم وضدّ التسلط المطالبة بالحرية والكرامة إنّما نالت الشرعية والاعتراف بها من قبل المنظمات الدولية والحكومات المختلفة؛ ممّا يعني اتّفاق العقلاء على رفض الظلم والتسلّط غير المشروع ومصادرة الحريّات والتحكّم في شؤون الأمّة بلا عدلٍ ولا إنصاف.
مفهوم الثورة وانطباقه على التحرّك الحسيني
من خلال ما قرّرناه سابقاً في معنى الثورة يتّضح أنّ الحراك الحسيني هو ثورة حقيقية تنطبق عليه التعاريف المذكورة، فهو من جهة تحرّك يضمّ أفضل شخصية دينية واجتماعية في ذلك الوقت، وسيأتي لاحقاً في بيان مؤهّلات الإمام الحسين× أنّه لا يشكّ أحد في الموقعية المتميزة التي يحضاها الإمام الحسين×، وأنّه سيّد القوم في وقته. فالتحرّك إذن كان يمثلّ القمّة من جهة القيادة، فهو تحرّك بارز وظاهر ومن أعلى المستويات، بل حرّك معه الأُمّة بكافّة أطيافها، بحيث إنّ المجتمع الإسلامي بما فيه من صحابة وتابعين واكب وراقب ذلك التحرّك، منذ خروج الإمام الحسين× من المدينة إلى مكّة، وثمّ إلى حين وصوله إلى كربلاء.
ومن جهةٍ أُخرى فإنّ الثورة كانت تهدف إلى تغيير الواقع المأساوي الذي تمرّ به الأُمّة الإسلامية، سواء على صعيد الخلافة أو على صعيد فقدان المجتمع لإرادته، وعدم قدرته على الوقوف بوجه الظلم، وقد نجح في إحداث ذلك التغيير، فقد استطاع الإمام الحسين× أنْ يكشف زيف الخلافة وانحرافها عن جادّة الشريعة، وأنّها لا تمثل القداسة الدينية، بل هي خلافة سياسية غير مرتبطة بالإمامة الدينية المقدّسة لدى الشارع الحكيم، فلم يَعد يزيد ولا الخلفاء الذين جاءوا من بعده يمثّلون عند المجتمع الخلافة الإلهية، بل هم حكّام سياسيون لا ربط لهم بدين الله وشرعه، فالحسين× استطاع أنْ يزيل القناع الشـرعي الذي تلبّس به الحكّام، ونالوا به القداسة من المجتمع، وكانوا يمثلون الحكم الديني والحكم السياسي، وكانوا يشرّعون في دين الله؛ فيحلّون حرامه ويحرّمون حلاله، لكنّ ثورة الإمام الحسين× أوقفت هذه الفكرة، وأوضحت أنّ هؤلاء حكّام سياسة فقط، ولا ربط لهم بدين الله.
كما أنّ الإمام الحسين× استطاع أنْ يحرّك ضمير الأُمّة ويشرعن لها الخروج على حكّام الجور إحياءً وتطبيقاً لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالفعل حصلت ثورات عديدة بعد ذلك منادية بالطلب بثأره، ولم تخشَ من قول كلمة الحقّ في وجه الحاكم الجائر، وهكذا يمكن أنْ يلحظ الباحث نتائج عديدة ترتّبت على حركة الحسين×، فهي إذن حركة تمثّلت قيادتها بأفضل النُّخب الموجودة، وحقّقت تغييرات جذرية في واقع الأُمّة الإسلامية.
وقد يُقال: إنّ الأصحّ من حيث الاصطلاح هو استخدام اصطلاح (النهضة) على حركة الإمام الحسين× وعدم اصطلاح لفظ (الثورة) عليه؛ لأنّ النهضة تمثّل عنواناً أشمل وأوسع وتتضمن تحقيق النتائج المبتغاة، بينما الثورة قد تطلق حتّى على ذلك الحراك غير المبتني على أُسس صحيحة، أو لم يحقّق نتائجه، فكثير من الثورات قامت وانتصـرت ظاهرياً، لكنّها لم تحقّق نتائجها المعلنة، ولم يتبع ذلك تغيير وتطوّر في حالة البلد والمجتمع، أي إنّه قد تحصل الثورة ولا تحصل النهضة، وقد تحصل الثورة ويستتبعها تغيير جذري في الواقع وتحقيق للأهداف المعلنة، فتتحوّل إلى نهضة.
والحقيقة أنّ الكلام المتقدّم لا يعدو الاصطلاح ليس إلاّ، خصوصاً إذا ما عرفنا أنّ اصطلاح (النهضة) واصطلاح (الثورة) كلاهما اصطلاحان متأخّران لم يكن لهما وجودٌ سابقٌ؛ لذا لم يكن لهما معنًى واضحٌ ومتميّز في الخارج، وقد ذكرنا فيما سبق عدّة تعريفات للثورة، ووقفنا على معناها اللغوي، ثمّ مازجنا بين اللغة والعرف والتعاريف المختلفة لها، وخلصنا إلى أنّ الحراك إذا قامت به الجماهير أو النخب، وكان بارزاً وظاهراً، ولم يكن خاملاً يُسمّى ثورة، سواء حقّق هدفه المنشود، أم لم يحقّقه. وعرفنا أيضاً أنّ الثورة لذاتها لا تكتسب القداسة، بل تكتسب قداستها من غرضها وأهدافها، وحينئذٍ فلا مناص من الالتزام بأنّ التحرّك الحسيني كان ثورة كُبرى تحقّقت فيها الأهداف المنشودة، بل لازالت ثمارها تُؤتي أُكلها حتّى هذا اليوم.
فهذا التحرّك المصحوب بتحقيق النتائج، والذي اصطلح عليه كثير من العلماء بـ(الثورة)، فليصطلح عليه بعض آخر بـ(النهضة)، ولا مشاحّة في الاصطلاح، ما دام مفهوم الثورة يصدق على الحراك المحقّق لنتائجه، خصوصاً إذا ما لاحظنا أنّ كلا الاصطلاحين يُطلقان على التغيير الجذري في المجالات المختلفة المتعلّقة بالدولة والمجتمع، فيقولون: ثورة صناعية، وثورة زراعية، وثورة اقتصادية، وثورة رياضية، وهكذا. وكذلك يُقال: نهضة صناعية، ونهضة زراعية، ونهضة اقتصادية، وهكذا.
الفصل الثاني: مشروعية الثورة في ضوء صلح الإمام الحسن×
مشروعية الثورة في ضوء صلح الإمام الحسن×
وفاة النبيّ’ وتغيير مسار الأُمّة
لم تكن ثورة الحسين× وليدة ساعتها، بل هي نتاج لعدّة متغيرات وظروف طرأت على المجتمع الإسلامي؛ لذا لا يمكن دراستها بصورة منفصلة عمّا سبقها من أحداث؛ لما لتلك الأحداث من تأثير مباشر على حدوثها، وحيث إنّ تلك الأحداث مترابطة ومتسلسلة، وكلّها أسهمت في تلك الثورة؛ كان من الضروري أنْ نستعرض أهمّ ما مرّ به المجتمع الإسلامي من بعد وفاة الرسول’ وإلى حين صلح الإمام الحسن×، حتّى يتّضح جليّاً كيف أدّت تلك التحوّلات والظروف إلى تولّي معاوية أُمور المسلمين بعد الهدنة والصلح الذي تمّ بينه وبين الإمام الحسن×، ويتّضح معه دور ذلك الصلح في ثورة الإمام الحسين×
1ـ نبذة عن السقيفة وتداعياتها
تقدّم في المبحث الأول ضرورة وجود القائد والحاكم والإمام في المجتمع، وأنّ النبيّ هو القائد والإمام للمسلمين في وقته، وكان أولى بهم من أنفسهم، وعرفنا أيضاً أنّ النبي’ لم يترك أمر هذه الأُمّة سدى تتقاذفه الأهواء، بل نصّ في أكثر من مناسبة، وفي أكثر من موقف على الخلفاء من بعده، وهم أهل البيت^، وأوّلهم عليّ بن أبي طالب×.
إلّا أنّه وبعد وفاة النبيّ’ مباشرة حدثت تغييرات جذرية في تحديد مسار الأُمّة الذي أراده النبي’، ففي حين كان عليٌّ وثلّة من بني هاشم يباشرون أمر النبيّ ويجهزونه، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة بقيادة سعد بن عبادة زعيم الخزرج، بهدف تنصيبه خليفة على المسلمين، فخطب بهم سعد، واتّفقوا على توليته أُمور المسلمين، ثمّ اختلفوا فيما بينهم فيما لو رفضت قريش ذلك، وأدّعت أنّها أولى بالخلافة، فقالت طائفة منهم، نقول: «منّا أمير ومنكم أمير. فأجابهم سعد بأنّ ذلك أوّل الوهن[73]، وبالفعل وصل خبر السقيفة إلى عمر[74]، أو إلى أبي بكر على اختلاف الأخبار[75]، فأخبر أحدهما الآخر، وتركوا منزل النبيّ’، واصطحبوا معهم أبو عبيدة، وأقبلوا مسرعين نحو السقيفة.
فكثر الكلام واللغط فيما بينهم وبين الأنصار، وظهرت الحزبية والقبلية بصورة بيّنة، وأخذ كلّ فريق يبيّن فضائله ومناقبه وأولويته بالخلافة، وبات واضحاً أنّ قريش ترى أنّ الخلافة لها حصراً، فكان أبو بكر يخاطب الأنصار بقوله: «نحن الأُمراء وأنتم الوزراء. فرفض الأنصار ذلك، لكنهم قبلوا باقتسام السلطة، فقال حباب بن المنذر: «لا والله، لا نفعل، منّا أمير ومنكم أمير[76].
لكنّ قريش أبت إلّا أنْ تكون الخلافة لها، واحتدم النقاش والجدال فيما بينهم، حتّى أنّ عمر قال: «والله، لا يخالفنا أحد إلّا قتلناه[77]. وكثُر الكلام بينهم حتّى كاد أنْ يكون بينهم حرب[78]، كما أنّ الأنصار انشقّوا على بعضهم أيضاً، وأوّل من نكث هو بشير بن سعد الخزرجي، وقد خطب خطبةً يدعو فيها إلى تأمير قريش. ثمّ إنّ عمر دعا إلى مبايعة أبي بكر، وأخذ بيده فبايعه وبايعه الناس[79]، بل ورد أنّ بشير سبق عمر إلى مبايعة أبي بكر!
وحين رأى الأوس ـ وهم الخصم العتيد للخزرج ـ ما فعل بشير، وما تدعو إليه قريش من تأمير نفسها، وما تطلب الخزرج من تأمير سعد بن عبادة، قال بعضهم لبعض ـ وفيهم أسيد بن حضير، وكان أحد النقباء ـ: والله، لئن وليتها الخزرج عليكم مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة، ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً، فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا إليه فبايعوه، فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من أمرهم[80].
وتنقل بعض الأخبار أنّ الأنصار الذين حضروا السقيفة أو بعضهم، عند ذلك قالوا: «لا نبايع إلّا علياً![81]، فلم يذكروا عليّاً إلّا بعد فوات الأوان، وعرفوا أنّ الخلافة قد فلتت من أيديهم!
وهكذا تمّت البيعة لأبي بكر، وسط فتنةٍ وشجار، حتّى أنّ سعد بن عبادة كاد أنْ يُقتل، فقال قائلٌ من الأنصار: «أبقوا سعد بن عبادة لا تطؤوه. فقال عمر: «اقتلوه، قتله الله![82].
ويمكن أنْ نسجّل على حادثة السقيفة عدّة ملاحظات:
1ـ إنّها تمثّل البذرة الأولى للانحراف عن المنهج النبوي المبارك، فقد أغفلوا نصوص النبيّ وأقواله في عليّ وأهل البيت^، ولم يُولُوها أيَّ اهتمام يُذكر، في حين أنّ عليّا كان مشغولاً بتجهيز النبيّ، وبحسب السير الطبيعي للأُمور، فإنّه لم يكن ليشكّ في أنّ الخلافة ستكون له لا لغيره، وهذا ما يجسده لنا الحوار الدائر بينه وبين العبّاس، حين طلب منه أنْ يبايعه أمام الناس؛ حتى لا يختلف عليه اثنان، فأجابه عليّ: «أَوَ مِنْهُمْ مَنْ يُنْكِرُ حَقَّنَا وَيَسْتَبِدُّ عَلَيْنَا؟! فَقَالَ الْعَبَّاسُ: سَتَرَى أَنَّ ذَلِكَ سَيَكُونُ. فَلَمَّا بُويِعَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ يَا عَلِيُّ؟[83].
ولربّما أنّ عليّاً× أراد أنْ يبيّن أنّ خلافته وإمامته إنّما هي بالنصّ لا بالبيعة، وأنّ هذا الحقّ ثابتٌ له دون غيره، وأنّ قبوله بالبيعة من أوّل وهلةٍ يعدّ مساهمة منه في تغيير النظرية الإسلامية في تعيين الخليفة، وهي نظرية النصّ.
ومن الواضح أنّ الالتزام بالنصّ سوف يجعل الخلافة في بني هاشم حصراً، وهذا ما لا يروق لقريش ولا للأنصار.
وكيف ما كان، فالسقيفة تمثّل بذرة الانحراف الأُولى، وكاد أنْ يحدث بسببها فتنة عظيمة وقتل وقتال يجرّ على المسلمين الويلات، وقد أشار إلى ذلك عمر حين قال: «...فلا يغترنَّ امرؤٌ أن يقول: إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة، وتمّت ألا وإنّها قد كانت كذلك، ولكنّ الله وقى شرّها[84].
وإذا كانت فلتة، فهذا يعني أنّها لم تأتِ بمشورة ولا تمعّن ولا رويّة، بل لم تكن مستندة إلى أمرٍ شرعي واضح عند الصحابة، وإلا لما صحّ القول بأنّها فلتة!
2ـ إنّ أصحاب السقيفة كما عمدوا إلى تغييب النص، فكذلك لم يثبتوا الشورى ولا الإجماع، بل لم يدّعوا أنّ الخلافة تنعقد بالشورى أو الإجماع؛ ولذا سارع الأنصار إلى سقيفتهم من دون شورى بقيّة الصحابة، وأرادوا تولية سعد بن عبادة، وحين سمع عمر وأبو بكر بالخبر أسرعوا في القدوم إليهم دون مشاورة علي وبني هاشم وغيرهم من المهاجرين... فالسقيفة لم تؤمن لا بمبدأ النص ولا بمبدأ الشورى، فضلاً عن الإجماع.
وأمّا البيعة العامّة التي تحصل عادةً بعد إحكام الأُمور وتعيين شخص الخليفة فعليّاً، فهي لا تمثّل شيئاً شرعيّاً إطلاقاً؛ لأنّ الخليفة الذي عُيّن إمّا أنْ يكون كسب الشرعية أو لا، فإنْ كان كسب الشرعية، فهذا يعني أنّه كسبها بدون مشورة غالب المسلمين، فكيف صار خليفة؟ وما هي الأُسس التي استندوا إليها في ذلك؟ وما الغرض من البيعة لخليفة شرعي، سواء بايعه الناس أم رفضوا ولم يبايعوه؟! خصوصاً أنّ السقيفة خلت من غالبية المهاجرين، بما فيهم أهل الحلّ والعقد، فكما سيأتي أنّه لم يحضر السقيفة علي وطلحة والزبير وعمار والعبّاس، بل وعامّة بني هاشم! فلا يمكن القول إنّ بيعة أهل الحلّ والعقد كافية، فهي لم تحصل أيضاً.
وأمّا الشقّ الثاني، وهو فرض أنّ الخليفة المُفترض لم يكسب الشرعية، وإنّما يكسبها بعد البيعة العامّة، فلماذا إذن تجب بيعة شخص لم يكسب الشرعية فعلاً؟ فعلامَ التهديد وإجبار الناس على البيعة؟ أفهل ينصّ القرآن أو النبيّ’ على وجوب بيعة شخص لم يكسب الشرعية بعد؟
ولعلّه لهذه المشاكل ظهرت محاولات للترميم فيما بعد، بدعوى أنّ الخلافة تنعقد ببيعة عددٍ قليل من أهل الحلّ والعقد، بل يكفي الواحد! وهذا في الحقيقة ممّا يُضحك الثكلى، فكيف يتأمر شخص على أُمّة الإسلام بترشيح شخصٍ واحدٍ له؟ فما هي المبرّرات الشرعية لذلك؟ والحقيقة إنّ فتح باب هذه المسألة يجرّنا إلى بحوث عديدة خارج مجال هذه الدراسة، ولكن نُشير إلى نقطة مهمّة، وهي أنّنا نبحث عن شرعية السقيفة، وما حصل فيها إلى حين البيعة العامّة، فلم نجد دليلاً شرعياً واحداً على ذلك، في حين أنّ المقابل صادر المطلوب، وانطلق من السقيفة وغيرها من طرق تنصيب الحكومات، ثمّ راح يُنظّر ويُشرعن لها.
وبمعنًى آخر: إنّه حاول تبرير الواقع الخارجي، وجعله هو المعيار في شرعية الأمور، ولذلك تعدّدت عنده الرؤية في طريقة الاستخلاف تبعاً لتعدد الواقع الخارجي، بينما الإنصاف يقتضي أنْ نبحث ذلك الواقع الخارجي، ونرى هل كان يملك دليلاً شرعياً على تحرّكه أم لا؟
ولذا؛ فإنّه طبقاً لنظرية النص تكون الأُمور واضحة في كيفية تعيين الخلافة، ويتّضح موقف الإمام عليّ في عدم مبايعة أبي بكر، لا في السقيفة ولا في البيعة العامّة، ويتّضح عدم رضوخ وانقياد الزهراء‘ لخلافتهم حتى وفاتها، في حين لا نجد إجابة تملأ الوجدان وتُريح الضمير حين نتمسّك بطرق الاستخلاف التي يقولون بها.
3ـ بدت في تلك الواقعة حالات التفاخر وحبّ الملك والسلطان واضحة، فقريش تطمح بالخلافة، بل وتقصي منافسيها وترفض حتى حالات الشراكة، بحجّة أنّها أفضل العرب وأنّها هاجرت مع النبي’، فهي أولى بالخلافة، والأنصار يرون أنفسهم أولى من غيرهم؛ لنصرتهم النبيّ وإيوائهم له، وبدا التفكّك والخلاف بين الصحابة واضحاً، حتى كاد أن يقع بينهم القتال.
4ـ إنّ الأحقاد التي كانت بين الحيّين الأوس والخزرج ـ وهما من الأنصار ـ لم تنطفئ، وإنْ خَفُتَ صوتها خلال حياة النبيّ’، لكنّها سرعان ما عادت، ولذا؛ يمكن أنْ نسجّل ملاحظة مهمّة، وهي أنّ الأنصار حين اجتمعوا بقيادة سعد وهو من الخزرج، لم يتحمّل جماعة من الأوس ذلك، فوشوا بأصحابهم من الخزرج، وأوصلوا الخبر إلى عمر أو أبي بكر، فقد ذكرت الأخبار أنّ الوشاة كانوا اثنين من الأوس، وهما: معن بن عدي، وعويم ابن ساعدة، وهما من الأوس[85]! وكذلك فإنّ الذين بادروا لبيعة أبي بكر كانوا من الأوس؛ خشية أنْ يتأمّر الخزرج عليهم.
5ـ نتساءل عن السرّ الذي جعل عمر وأبو بكر يتركان بيت النبيّ’ بمعيّة أبي عبيدة، ولم يخبرا الإمام عليّ بذلك، فإذا كانا يعتقدان بخطورة الموقف وأهميّته على الحالة الإسلامية آنذاك، بحيث تركوا جثمان النبيّ بلا تجهيز، وذهبوا مسرعين للسقيفة، فلماذا لم يستشيرا عليّاً ولا أحداً من بني هاشم في الأمر؟ أفهل يشكّان في غيرة عليّ على الإسلام، أو ينكرون شجاعته ووقفاته في الدفاع عن النبيّ والشريعة، أو أنّ الخطورة كانت تتعلّق بمصالح شخصية، وأنّ هناك أمراً مبيّتاً حِيكت خيوطه وراء الستار، وأُريد له أنْ يتمّ دون معرفة عليّ به؟!
6ـ وأخيراً ما الذي جعل الأنصار يجتمعون سرّاً، والنبيّ لمّا يُدفن بعد، فهل كانت غيرتهم على الإسلام تمنعهم من الذهاب إلى بيت النبيّ والتشاور مع بني هاشم والمهاجرين حول مسألة الخلافة بعد النبيّ، أم كان الهدف السيطرة على الحكم دون معرفة أحد؟ لذا كانوا متخوّفين من رفض قريش لرأيهم، فاقترحوا عند ذاك تقاسم السلطة، الأمر الذي رفضه سعدٌ واعتبره أوّل الوهن!
والخلاصة: إنّ أحداث السقيفة تعطيك انطباعاً واضحاً عن أنّ النفوس كانت ميّالة للحكم والسلطة، وأنّ النزعات القبلية لا زالت هي الحاكمة والمتأصّلة، وأنّ الابتعاد عن روح الإسلام وتعاليمه باتت واضحة أمام الجميع.
2ـ عليّ وبنو هاشم وجمع من الصحابة لم يبايعوا
والجدير بالذكر هنا أنّ البيعة التي حصلت لأبي بكر لم تتمّ بإجماع المسلمين، وكان عدد كبير من المهاجرين والأنصار يرون الخلافة لعليّ×، ولم يشكّوا في ذلك، فقد ذكرنا سابقاً أنّ عليّاً لم يكن يشكّ في أنّ الخلافة له دون غيره، ونقل الزبير بن بكار، عن محمّد بن إسحاق، قال: «وكان عامّة المهاجرين وجلّ الأنصار لا يشكّون أنّ عليّاً هو صاحب الأمر بعد رسول اللّه’[86].
وقال اليعقوبي بعد أنْ ذكر بيعة أبي بكر في السقيفة: «وجاء البراء بن عازب، فضرب الباب على بني هاشم، وقال: يا معشر بني هاشم، بويع أبو بكر. فقال بعضهم: ما كان المسلمون يُحدثون حَدثاً نغيب عنه، ونحن أولى بمحمد. فقال العباس: فعلوها وربِّ الكعبة. وكان المهاجرون والأنصار لا يشكّون في علي، فلمّا خرجوا من الدار قام الفضل بن العباس، وكان لسان قريش، فقال: يا معشر قريش، إنّه ما حقّت لكم الخلافة بالتمويه، ونحن أهلها دونكم، وصاحبنا أولى بها منكم، وقام عتبة بن أبي لهب، فقال:
|
ما
كنت أحسب أنّ الأمر منصـرفٌ |
عن
هاشمٍ ثمّ منها عن أبي الحسن |
|
عن
أوّل الناس إيماناً وسابقة |
وأعلم
الناس بالقرآن والسنن[87]. |
وقد تخلّف عدد كبير من الصحابة عن بيعة أبي بكر، فيهم ثلّة من أعيانهم وعلى رأسهم علي، وطلحة، والزبير، وبنو هاشم، وسجّل لنا التأريخ عدداً من الوثائق التي تنصّ على ذلك:
جاء في البخاري عن عمر: «حين توفّى الله نبيه (صلّى الله عليه وسلّم) أنّ الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنّا عليّ والزبير ومن معهما[88].
ونصّ في موضعٍ آخر على أنّ فاطمة وجدت على أبي بكر، وهجرته ولم تكلّمه حتّى توفيت. وكانت قد عاشت بعد النبي’ ستّة أشهر، وأنّ عليّاً لم يكن قد بايع في تلك الفترة[89].
وقال اليعقوبي: «تخلّف عن بيعة أبي بكر قومٌ من المهاجرين والأنصار، ومالوا مع علي بن أبي طالب، منهم: العباس بن عبد المطلب، والفضل بن العباس، والزبير بن العوام بن العاص، وخالد بن سعيد، والمقداد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسر، والبراء ابن عازب، وأُبي بن كعب[90].
وقال الطبري صاحب الرياض النضرة: «وتخلّف عن بيعة أبي بكر يومئذٍ: سعد بن عبادة في طائفة من الخزرج، وعلي بن أبي طالب وابناه، والعباس عمّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) وبنوه في بني هاشم، والزبير وطلحة، وسلمان وعمار وأبو ذر والمقداد، وغيرهم من المهاجرين، وخالد بن سعيد بن العاص[91].
وقال ابن الأثير: «وتخلّف عن بيعته: علي، وبنو هاشم، والزبير ابن العوام، وخالد بن سعيد بن العاص، وسعد بن عبادة الأنصاري، ثمّ إنّ الجميع بايعوا بعد موت فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، إلاّ سعد بن عبادة، فإنّه لم يبايع أحداً إلى أنْ مات، وكانت بيعتهم بعد ستة أشهر على القول الصحيح[92].
وقد ذكر أبو الفداء تخلّف جماعة من بني هاشم، والزبير، وعتبة بن أبي لهب، وخالد ابن سعيد بن العاص، والمقداد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبي ذر، وعمار بن ياسر، والبراء بن عازب، وأُبي بن كعب، وإنّهم مالوا مع عليّ بن أبي طالب[93].
وممَّن لم يبايع أيضاً: فروة بن عمرو[94]، وأبو سفيان[95]، وغيرهم كُثر، ولسنا هنا بصدد تحقيق وإحصاء مَن لم يبايع، بل أردنا أنْ نُثبت أنّه لا إجماع على بيعة أبي بكر، بل ولا شورى، ولا بيعة من قبل أهل الحلّ والعقد، فالذين ذكرناهم في هذا الإيجاز، هم كالتالي:
1ـ علي بن أبي طالب.
2ـ الحسن بن علي.
3ـ الحسين بن علي.
4ـ العباس بن عبد المطلب.
5ـ القثم بن العبّاس.
6ـ الفضل بن العبّاس.
7ـ البراء بن عازب.
8ـ الزبير بن العوام.
9ـ طلحة بن عبيد الله.
10ـ المقداد.
11ـ أبو ذر الغفاري.
12ـ عمّار بن ياسر.
13ـ سلمان الفارسي.
14ـ أُبي بن كعب.
15ـ سعد بن عبادة.
16ـ خالد بن سعيد.
17ـ عتبة بن أبي لهب.
18ـ فروة بن عمرو.
19ـ أبو سفيان.
وغيرهم كُثر، خصوصاً أنّ بعضهم أطلق بعدم مبايعة بني هاشم من دون تخصيصهم بأفراد معيّنين، فضلاً عن وجود طائفة من الخزرج لم تبايع أيضاً.
ومنه يتّضح عدم وجود شورى ولا إجماع في بيعة أبي بكر.
ولا يرد ما قد يُقال: إنّ البيعة قد حصلت لاحقاً، وتحقّق الإجماع فيما بعد، فمضافاً إلى عدم وجود دليلٍ واضحٍ على مبايعة الجميع، خصوصاً أنّ سعد بن عبادة لم يبايع إلى أنْ مات، فإنّه من الواضح أنّ تسجيل الاعتراض، وإظهار عدم المشروعية يكفي فيه عدم البيعة آناً ما، ولا يضرّ بعد ذلك البيعة لظروف ومصالح دينيّة معيّنة، بل إنّ السيّدة فاطمة بنت رسول الله’ لم تقرّ ولم تخضع لخلافة أبي بكر ولا لحظة، وماتت وهي غاضبة وواجدة عليه[96]، وهذا يشكّل نقطة أساسية، ومنعطفاً خطيراً ينبغي التنبّه إليه، فإنّ من المتّفق عليه أنّ مَن مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية، فهل أنّ فاطمة وهي بنت النبي’ ماتت ميتة جاهلية، وستُساق إلى النار؟! مع أنّها سيدة نساء العالمين، ومَن أغضبها أغضب الله ورسوله، أو أنّها لا ترى شرعية خلافة أبي بكر، وترى أنّ إمامها هو عليّ×؟!
لا مناص من التمسّك بالأمر الثاني، خصوصاً مع مراعاة الروايات الواردة في فضائلها، وهي كثيرةٌ جدّاً، أضف إلى أنّ أهل السنّة يرون أنّ جميع الصحابة من أهل الجنّة!
وما قد يُقال: من أنّه لا بيعة على النساء، فلا ينقض على مشروعية خلافة أبي بكر بعدم مبايعة الزهراء له، فهو مجرّد تفصّي من الإشكال بلا حجّة شرعية؛ ذلك لأنّ عدم البيعة للنساء لا يعني أنّ المرأة لا يجب عليها الإيمان بإمام وخليفة زمانها، والانقياد لأوامره ونواهيه، بل معناه أنّه لا يجب عليها الخروج كالرجال وإعطائه البيعة بالشكل المعروف، وإلّا فالإقرار بإمامته وخلافته واجبٌ على الجميع، فحديث: «مَن مات وليس عليه إمام...[97] صريح في شموله للجميع ولا يُفرّق بين رجل وامرأة...
وإذا قلنا بخروج المرأة منه؛ لأنّها ليست من أهل الحلّ والعقد ولا تجب عليها البيعة، فذلك يلزم خروج جميع الرجال من الصحابة والتابعين الذين ليسوا من أهل الحلّ والعقد، ومعه لا تجب طاعة الإمام ولا الخضوع له من قبل أكثر الأُمّة الإسلامية، وهو منافٍ للحديث الشريف بصورة جليّة وواضحة.
والنتيجة: إنّ عدم خضوع الزهراء لأبي بكر يدلّ على عدم اعتقادها بخلافته، وإيمانها طبق النصّ الشرعي بإمامة عليّ×.
بعد أنْ عرفنا أنّه لم تكن هناك شورى في السقيفة، وأنّ عمر وصف استخلاف أبي بكر بأنّه فلتة، جاء الدور ليتولّى عمر شؤون المسلمين بنصٍّ من أبي بكر فقط، وسط اعتراضات الصحابة وعدم موافقتهم على ذلك، إلّا أنّ أبا بكر لم يُولِ اعتراضهم أيَّ قيمة، وأصرّ على استخلاف عمر من بعده! ففي مُصنّف ابن أبي شيبة وغيره: «لمّا حضرت أبا بكرٍ الوفاة أرسل إلى عمر ليستخلفه، قال: فقال الناس: أتستخلف علينا فظّاً غليظاً، فلو ملكنا كان أفظّ وأغلظ، ماذا تقول لربِّك إذا أتيته وقد استخلفته علينا؟! قال: تخوفوني بربي، أقول: اللهم أمّرت عليهم خير أهلك[98].
فهذا يكشف على أنّ أبا بكر لم يستشر الصحابة في قضية تولّي عمر بن الخطاب، ولم يعبأ بكلام المعترضين، بل ليس في ذهنه شيء اسمه الشورى؛ إذ لو كان أبو بكر يؤمن بنظرية الشورى فلا معنى لتنصيبه عمر بهذه الكيفيّة، خصوصاً مع اعتراض الصحابة بصورة صريحة.
إذاً؛ عادت نظرية النصّ للساحة من جديد، بعد أنْ غُيّبت في السقيفة، لكنّه نصٌّ من نوعٍ آخر، فالنصّ الذي غُيّب في السقيفة هو النصّ الصادر عن النبيّ’ المعصوم في تنصيب عليّ× خليفةً على الأُمّة، لكنّ هذا النصّ هو من خليفةٍ لم يستمدّ شرعية خلافته بصورة صحيحة، ويحمل في ثناياه ردّاً للجميل، وتكميلاً للمشروع الذي ابتدأه الخليفة عمر في يوم السقيفة حين نادى ببيعة أبي بكر، فلا داعي لسقيفةٍ أُخرى، ولا اجتماع مع المهاجرين فضلاً عن الأنصار، بعد أنْ استطاعت السقيفة أنْ تُبعد البيت العلوي عن سدّة الحكم، ولا ضير حينئذ أنْ تكون الخلافة بالنصّ ما دامها تحقّق أغراض الخليفة، وتُكمل مسلسل الإقصاء الذي مُورس يوم السقيفة.
تربّع الخليفة عمر على سدّة الحكم، والأُمور تسير بخلاف ما رسم لها الرسول الأكرم’، وبدأت أمارات الانحراف تطفو على السطح، ففي سنّة (20) للهجرة، قام عمر بتطبيق مبدأ التفاضل في العطاء، «ففضّل السابقين على غيرهم، وفضل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين، وفضّل المهاجرين كافّة على الأنصار كافّة، وفضّل العرب على العجم، وفضّل الصريح على المولى، وكان قد أشار على أبي بكر أيام خلافته بذلك، فلم يقبل...[99]. كما فضّل مضر على ربيعة، ففرض لمضر ثلاثمائة ولربيعة في مائتين[100]، كما أنّه فاضل بين الأنصار بتقديم الأوس على الخزرج، فبدأ برهط سعد بن معاذ الأشهلى من الأوس، ثمّ الأقرب فالأقرب لسعد[101].
وطبيعيٌّ أنّ لهذا التمييز نتائج سلبية عدّة من تكوين طبقية، وتنازع قبلي وعنصري يؤدّي إلى تفتيت لُحمة المجتمع الإسلامي.
كما أنّ عَهْدَ عمر شهد تغييرَ وتحريفَ بعض الأحكام كحجّ التمتّع مثلاً، كما أنّه كانت تغيب عنه العديد من الأحكام؛ ممّا اضطره في كثير من الأحيان الرجوع إلى عليّ×، حتّى أنّه كان يتعوّذ بالله من معضلةٍ ليس لها أبو حسن[102].
ثمّ إنّه أكمل مشوار الاضطراب في كيفية تعيين الخليفة، فأوكل الأمر من بعده إلى ستّة كلّهم من قريش يختارون خليفة من بينهم، وهؤلاء الستّة هم: عليّ بن أبي طالب، وعثمان ابن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، مع ترجيح الكفّة التي فيها عبد الرحمن بن عوف عند التساوي [103].
وقد أسهم هذا الأمر في تفكيك وتشتيت عُرى المسلمين؛ إذ كلّ جماعة مالت إلى واحدٍ من هؤلاء الستّة، وقد اعترف معاوية بن أبي سفيان بذلك، قال: «لم يشتّت بين المسلمين ولا فرّق أهواءهم ولا خالف بينهم إلاّ الشورى التي جعلها عمر إلى ستة نفر... فلم يكن رجلٌ منهم إلاّ رجاها لنفسه، ورجاها له قومه، وتطلّعت إلى ذلك نفسه...[104].
انتهت الشورى السداسية باستيلاء عثمان على السلطة، بعد أنْ بايعه عبد الرحمن بن عوف، الأمر الذي رفضه الإمام عليّ؛ لمعرفته وعلمه بأنّ ذلك استمرار لمخطّط إبعاد البيت العلوي عن الخلافة، فقال في ذاك: «إنّما آثرته بها لتنالها بعده، دقّ الله بينكما عطر منشم [105].
وفي نقلٍ آخر أنّه قال له: «حركّك الصهر، وبعثك على ما صنعت، والله، ما أمّلت منه إلّا ما أمّل صاحبك من صاحبه، دقّ الله بينكما عطر منشم [106].
واستمرت الأوضاع ابتعاداً عن جادّة الشريعة، وظهرت من عثمان انحرافات عديدة، إذ بدأها بالعفو عن عبيد الله بن الخطاب قاتل الهرمزان وابنة أبي لؤلؤة الصغيرة، الأمر الذي رفضه الإمام عليّ× ومعه كبار الصحابة، كما أنّه حوّل الخلافة وبيت المال إلى مُلكٍ عضوض يتقاسمه مع بني أُميّة، فقد قام بتولية بني أُميّة، واستأثر هو وإيّاهم ببيت مال المسلمين، وكان الصحابة يرفضون الأعمال المنكرة التي تصدر من أولئك الولاة، ويستعتبون عثمان فيهم، دون فائدة، فلا عزل للولاة ولا إصلاح للأُمور، بل كان يتحايل على الصحابة في بعض الأحيان، ويحاول خديعتهم، من قبيل توليته محمّد بن أبي بكر على مصر بعد شكاية أهلها له من واليه عبد الله بن أبي سرح، لكن الأمر كان خديعةً ماكرة، وكان الغرض هو قتل محمّد بن أبي بكر ومَن يقف معه، وسجن كلّ مَن يتظلّم للوالي، حسب الكتاب الذي وجدته الجماهير مرسلاً بيد أحد غلمان عثمان، موجّهاًً إلى واليه في مصر!
ومضافاً إلى هذا التحايل، فإنّه كان قد استخدم وسائل الترهيب في إسكات معارضيه والناقمين على سياسته من الصحابة، فكان أنْ نفى أبا ذر الغفاري إلى الربذة، وضرب عثمان بن ياسر بقسوة، وكذلك فعل بعبد الله بن مسعود؛ الأمر الذي زاد من حنق الناس عليه.
كما أنّ الناس كانت ممتعظةً من مخالفته لرسول الله، بل وكذا لأبي بكر وعمر حين أرجع عمّه ـ طريد رسول الله ـ الحكم بن أبي العاص إلى المدينة، بعد أنْ نفاه النبيّ مع ولده إلى الطائف، حيث كان من أشدّ الناس إيذاء له’، فلمّا توفيّ النبيّ’ كلّم عثمانُ أبا بكر في إرجاعه فرفض ذلك، ثمّ كلّم عمر في خلافته فرفض أيضاً، معلّلين رفضهم بعدم إمكانهم إيواء طرداء رسول الله.
لكنّ عثمان لم يكترث لذلك، فآوى طريد رسول الله، بل ولّاه على الصدقات ووهبها له!
هذه نبذة مختصرة من سياسات عثمان الخاطئة، التي انتهت بثورة جماهيرية كُبرى قادها الصحابة وكبار التابعين وقرّاء القرآن، أودت بحياة الخليفة عثمان[107]، والمثير في المسألة أنّ الثوار مَنعوا من دفنه! حتّى دفنه جماعة بسريّةفي حشّ كوكب[108]، وهي مقبرة لليهود![109].
انتهت حقبة خلافة عثمان، وقد تركت المجتمع طبقيّاً مفكّكاً مجزّءاً، بعيداً عن روح الشريعة وتعاليمها، غارقاً بألوان الفساد، وفي هذه الحال توجّهت الناس صوب عليّ× تطالبه بتولّي الخلافة، وما كان مثل عليّ أنْ يقبل بحكمٍ سياسي لا يقوم على أساس العدل الإلهي، فكان لا بدّ له من القيام بنهضة على كافّة الأصعدة، فقد أصرّ× على عزل ولاة عثمان الذين عُرفوا بالفساد في الأرض، رغم المطالبات بإبقائهم بدعوى الصلاح في ذلك، فولّى على البصـرة عثمان بن حنيف، وعلى الشام سهل بن حنيف، وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة، وعلى الكوفة عمارة بن شهاب[110]، وقيل: إنّه ثبّت على الكوفة أبا موسى الأشعري بإشارة من الأشتر[111]، ثمّ عزله فيما بعد[112]، وهذه هي الأمصار الكبيرة في دولة الخلافة آنذاك.
ومن الواضح أنّ قيس وعثمان وسهل كلّهم من الأنصار الذين تعرّضوا للإقصاء في تلك الفترة.
كما أنّه أوضح سياسته في الحقوق بقوله: «الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحقّ له، والقوي عندي ضعيف حتّى آخذ الحقّ منه[113].
كما إنّ الإمام× قرّر إعادة النظر في الأموال التي منحها عثمان إلى أصحابه ومقرّبيه، فأمر بإعادة جميع الإقطاعات التي اقتطعها عثمان، وجميع الأموال التي وهبها إلى الطبقة الموالية، إلى بيت المال، فقال×: «ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان، وكلّ مال أعطاه من مال الله، فهو مردود في بيت المال، فإنّ الحق القديم لا يُبطله شيء، ولو وجدتُه وقد تزوّج به النساء، وفرّق في البلدان، لرددته إلى حاله؛ فإنّ في العدل سعة، ومَن ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق [114].
كما أعلن أنّه سيوزّع المال بين المسلمين بالتساوي، وقام بذلك بصورة فعليّة، فقال لعبيد الله بن أبي رافع ـ كاتبه ـ: «ابدأ بالمهاجرين فنادِهم، وأعطِ كلّ رجلٍ ممَّن حضر ثلاثة دنانير، ثمّ ثنِّ بالأنصار، فافعل معهم مثل ذلك، ومَن يحضر من الناس كلّهم ـ الأحمر والأسود ـ فاصنع به مثل ذلك.
فقال سهل بن حنيف: «يا أمير المؤمنين، هذا غلامي بالأمس، وقد أعتقته اليوم!!، فقال: «نعطيه كما نعطيك، فأعطى كلّ واحد منهما ثلاثة دنانير، ولم يفضّل أحداً على أحد، وتخلّف عن هذا القَسم ـ يومئذٍ ـ طلحة، والزبير، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن العاص، ومروان بن الحكم، ورجال من قريش، وغيرها[115].
لم تَرُق السياسة العادلة للطبقة المنتفعة إبّان حكم عثمان، فبدأت ملامح خلافٍ جديد، وأخذت الأفكار تُحاك من وراء الستار، فالسياسات غير الحكيمة للخلفاء السابقين أوصلت المجتمع إلى هوّة سحيقة، وبدأت إفرازاتها تظهر على الساحة بصورة جليّة؛ ولذا نرى أنّ الأمير× عندما استدعى زعماء هذه الطبقة ليحاججهم على خلافهم إياه، أجابوه بأنّ سبب ذلك هو سيره على خلاف تقسيم عمر للأموال، وأنّه ساواهم بغيرهم[116].
وهكذا بدأت بوادر معركة يقودها الفريق المتضرّر من عدالة عليّ×، متّخذين دم عثمان ستاراً لتحقيق مطامعهم، فكانت معركة الجمل التي انتهت بهزيمتهم، وسقوط طلحة والزبير قتيلين مع آلاف القتلى من الطرفين.
وفي نفس الوقت فإنّ الشام لم تستجب لخلافة عليّ×، ولم تستقبل واليها الجديد، بل إنّ معاوية والي الشام سابقاً ـ أحد زعماء الطبقة المنتفعة ـ أخذ يعدّ العُدَّة للقضاء على حكومة الإمام×، خصوصاً أنّ عثمان قد وسّع في ولايته، فقد ضمّ إليه ولاية حمص وفلسطين؛ وبذلك مهّد له الخلافة، وأنشأ له مملكة مترامية الأطراف.
يقول الدكتور طه حسين: «وليس من شكٍّ في أنّ عثمان هو الذي مهّد لمعاوية ما أُتيح له من نقل الخلافة ذات يوم إلى آل أبي سفيان، وتثبيتها في بني أُميّة، فعثمان هو الذي وسّع على معاوية في الولاية؛ فضمّ إليه فلسطين وحمص، وأنشأ له وحدة شامية بعيدة الأرجاء...[117].
اتّخذ معاوية المطالبة بقتلة عثمان شعاراً لوقوفه بوجه عليّ×[118]، مع أنّه لم ينصره حين كان حيّاً، وليس هو بوليّ دمه بعد وفاته، بل ولم يقتصّ من قتلته حين تولّى الأُمور[119].
تمكّن معاوية من إعداد جيشٍ كبير متلاحمٍ في صفوفه على الباطل، وباتت الشام تُؤوي كلّ متمرد على حكم الإمام علي×، فقد انضمت إليها العناصر المنتفعة بعهد عثمان، والتي لا يروق لها الحكم الجديد، ولا يحقّق منافعها، بل ترى فيه خطراً عليها، فلاحت على الأُفق بوادر معركة جديدة، بعد فشل جميع المراسلات بين الفريقين.
نشبت معركة صفين، وكانت أعظم معركة وقعت في الإسلام، وسقط فيها آلاف القتلى، وكان عليّ× على أبواب النصر[120]، لكنّ خداع معاوية بمشورة ابن العاص برفعهم المصاحف، والدعوة إلى تحكيم كتاب الله بين الفريقين[121]، أدّت إلى انقسام في جيش الإمام علي×، وتفرّق في شملهم، فالآلاف المؤلّفة رفعوا سيوفهم بوجه الإمام علي× مطالبينه بالقبول بالتحكيم، ثمّ أجبروه على القبول بإبي موسى الأشعري حَكماً من طرف جيش الإمام×، ثمّ غيّروا رأيهم ورأوا أنّ ذلك كفر، فانفصلوا عن جيش الإمام× مطالبينه بالتوبة بعد أنْ حكّم الرجال في دين اللهـ وهو كفرٌ على زعمهم ـ حاول الإمام إعادتهم إلى طاعته، وأوضح لهم موقفه السابق من رفضه للتحكيم وقبولهم به، وما جرى من تداعيات كانوا هم السبب فيها، فلم ينفع[122]، وخيّمت أجواء حربٍ ثالثة، فكانت حروراء التي أسفرت عن مقتل جميع الخوارج باستثناء نفر قليل فقط.
هكذا هي الثروة، وها هي نتائج ولاة عثمان، ثلاثة حروب في غضون فترةٍ وجيزة، أنهكت قوى الإمام×، وشغلته عن القيام بثورته الإصلاحية الكبرى، وفتّت جيشه الذي صار فيما بعد ميّالاً إلى الدِّعة والراحة والسكون، رافضاً للحرب والقتال، إلاّ ثلّة قليلة، فبعد مهزلة التحكيم وما آلت إليه من خداع ابن العاص لأبي موسى، وعدم الوصول إلى نتيجةٍ شرعية ملزمة للفريقين، حاول الإمام× أنْ يجمع جيشه من جديد لقتال أهل الشام مجدّداً، لكن دون جدوى[123].
وفي هذا الوقت امتدّت يد الغدر الخارجية لتغتال الإمام× وهو في محراب صلاته!
تولّى الإمام الحسن الخلافة بعد أبيه، وأراد أن يسير على نفس سياسته في قتال حكومة الشام، والقضاء على يد الفتنة والتفرقة، لكنّ ظروف التفكّك والانهيار التي تسلّم بها الإمام الحسن× الخلافة، ازدادت سوءاً وتفكّكاً أكثر من تلك الفترة التي تسلّم بها الإمام علي× الخلافة، فالتخاذل والانهيار بات هو المسيطر، بعد أنْ دمّرت الحروب المتوالية معنويات هذا الجيش، ولذا فإنّ الإمام الحسن× أراد في لحظاته الأُولى أنْ يأخذ منهم العهد على الطاعة والولاء، فاشترط عليهم أنْ يكونوا مطيعين، يسالمون مَن سالم، ويحاربون مَن حارب، لكنّ المجتمع بدأ تخاذله من أوّل وهلة، فارتابوا من هذا الشرط، وقالوا: «ما هذا لكم بصاحب، وما يريد إلّا القتال[124].
كما أنّه× وفي خطوةٍ أُخرى مرغّبة لنفوس المقاتلين، وشادّة من عزائمهم، قام بزيادة أُعطياتهم مائة مائة[125].
وفي المقابل فإنّ معاوية لم يكن ليتفرّج على الإمام الحسن× وهو يجهّز الجيش ويُعدّ العدّة، فلمّا علم ببيعة الناس للحسن×، دسّ رجلاً من حِمْيَر إلى الكوفة، ورجلاً من القين إلى البصرة، ليكتبا إليه الأَخبار، ويُفسدا على الحسن× الأُمور، فعرف ذلك الحسن× وأمر باستخراج الحِمْيَري من عند حجّامٍ بالكوفة فأُخرج، فأمر بضرب عنقه، وكتب إلى البصرة فاستخرج القينيّ من بني سليم، وضُربت عنقه، ثمّ كتب الإمام× إلى معاوية: «أمّا بعد؛ فإنّك دسست الرجال للاحتيال والاغتيال، وأرصدت العيون، كأنّك تحبّ اللقاء، وما أوشك ذلك، فتوقعه إنْ شاء الله[126]. وهذا موقف صريح وواضح من الإمام الحسن× في أنّه على استعداد تامّ لقتال معاوية، والقضاء على الفتنة.
كما أنّ معاوية أخذ بالاستعداد لمعركةٍ جديدة، وكتب لعمّاله بموافاته لغزو العراق، وذكر في بعض كتبه أنّ بعض أشراف الكوفة وقادتهم كتبوا إليه يلتمسون الأمان لأنفسهم وعشائرهم[127].
وهذا النصّ إن صحّ ولم يكن خدعة من معاوية، فإنّما يفصح عن أنّ الخذلان كان من اللحظات الأُولى.
وأخذ معاوية بالتحرّك، ولمّا بلغ الإمام الحسن× خبر مسير معاوية، وأنّه قد بلغ جسر منبج، بدأ بتجهيز جيشه، واستنفرهم للجهاد فتثاقلوا عنه، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «أمّا بعد؛ فإنّ الله كتب الجهاد على خلقه، وسمّاه كُرهاً، ثمّ قال لأهل الجهاد من المؤمنين: اصبروا، إنّ الله مع الصابرين، فلستم ـ أيّها الناس ـ نائلين ما تحبّون إلاّ بالصبر على ما تكرهون، إنّه بلغني أنّ معاوية بلغه أنّا كنّا أزمعنا على المسير إليه، فتحرّك لذلك، فاخرجوا ـ رحمكم الله ـ إلى معسكركم بالنُّخيلة... فسكتوا، فما تكلّم منهم أحد، ولا أجابه بحرف[128].
فلمّا رأى عدي بن حاتم تخاذل الناس وتقاعسهم، قام وخطب فيهم، واستحثّهم على نصرة إمامهم، وتوجّه نحو الحسن× معلناً طاعته إياه، ثمّ قام بعده قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، ومعقل بن قيس الرياحي، وزياد بن صعصعة التيمي، فأنّبوا الناس ولاموهم وحرّضوهم، وأعلنوا طاعتهم للإمام الحسن×، فنشط الناس للخروج[129].
وهكذا تجهّز جيش الإمام للقتال، لكنّه يتألّف من فرق عدّة مختلفة الأهواء، فقد سار معه «أخلاط من الناس، بعضهم شيعة له ولأبيه، وبعضهم محكّمة ـ خوارج ـ يؤثرون قتال معاوية بكلّ حيلةٍ، وبعضهم أصحاب فتن وطمع في الغنائم، وبعضهم شُكّاك، وبعضهم أصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم، لا يرجعون إلى دين[130].
كما إنّ مجموعة من رؤساء القبائل كتبوا إلى معاوية بالطاعة له في السرّ، واستحثوه على السير نحوهم، وضمنوا له تسليم الحسن× أو الفتك به، وقد بلغ الحسن× ذلك[131].
كما أنّ قائد جيش الإمام الحسن× ـ عبيد الله بن عباس ـ قد تسلّل تحت جنح الظلام إلى جيش معاوية، بعد أن وصلته رسالة من معاوية يقول فيها: «إنّ الحسن قد راسلني في الصلح، وهو مسلّم الأمر إليَّ، فإن دخلت في طاعتي الآن كنت متبوعاً، وإلاّ دخلت وأنت تابع، ولك إن أجبتني الآن أن أُعطيك ألف ألف درهم، أُعَجِّل لك في هذا الوقت نصفها، وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر. فانسلّ عبيد الله ليلاً، فدخل عسكر معاوية، فوفّى له بما وعده، وأصبح الناس ينتظرون عبيد الله أن يخرج فيصلّي بهم، فلم يخرج حتى أصبحوا، فطلبوه فلم يجدوه، فصلّى بهم قيس بن سعد بن عبادة[132].
وإذا ضممنا إلى ذلك ما قام به معاوية من شراء الضمائر بالأموال والدسائس، كما هو الحال بالنسبة إلى عمرو بن حريث، والأشعث بن قيس، وحجّار بن أبجر، وشبث بن ربعي وغيرهم[133]، وقيامه ببثّ الشائعات، والتي منها أنّ قيس بن سعد ـ وهو قائد مسكن بعد فرار عبيد الله ابن عباس ـ قد صالح معاوية وصار معه، كما وجّه إلى عسكر قيس في مسكن مَن يتحدّث أنّ الحسن قد صالح معاوية وأجابه[134]، ونشر في المدائن إشاعة خبيثة وهي: أنّ قيس بن سعد قد قُتل فانفروا. فنفروا إلى سرادق الحسن×، فنهبوا متاعه حتى نازعوه بساطاً كان تحته[135].
إذا ضممنا كلّ هذه الأُمور وغيرها من الأحداث ـ التي لا يسع المجال لذكرها ـ وعرفنا أنّ معاوية هو الذي طلب الصلح، وأنفذ إلى الحسن× كُتب أصحابه الذين ضمنوا فيها الفتك بالحسن×، أو تسلميه إلى معاوية[136]، يتّضح جلياً ركون الإمام× إلى الصلح الذي اقترحه معاوية؛ إذ لا سبيل إلى النصر مع هذه الظروف، وأنّ القتال سيقضي على الثلّة المتبقية من خلّص أصحابه وأهل بيته، بما فيهم الإمام الحسين×.
فحفاظاً على المخلصين من أصحابه، ومحاولة استغلال الوقت في تجهيز جيش عقائدي قادر على النصر، ومحاولة فضح معاوية وأهدافه أمام الملأ، وعدم وجود خيار آخر أمامه يتناسب مع كونه إماماً يحمل مشروعاً إلهياً، قَبِل الإمام الحسن× بالصلح، بشروطٍ تُتيح عودة الخلافة فيما بعد إلى مسارها الصحيح، وهو ما سنتناوله في المبحث الآتي.
بعد أنْ تقاعس الناس عن نصرة الإمام الحسن× ومالوا إلى الدعة والراحة، وفرّ من فرّ منهم إلى جيش معاوية، وكاتبه غيرهم معلنين قبولهم بتسليم الإمام إليه، قبل الإمام الحسن بالصلح الذي عرضه عليه معاوية، وقد أراد بذلك مضافاً للحفاظ على أصحابه، أنْ يصدم الناس بحقيقة معاوية، ويريهم ما ستؤول إليه الأُمور، من أنّ أهداف معاوية لا تعدو الاستيلاء على السلطة بأيّ ثمنٍ كان، ولو كان بالقتل والتشريد، والتجويع والترهيب، وسيرون بأُمّ أعينهم أنّ معاوية ما عنده إلّا ً ولا ذمّة، ولا يفي بشروط ولا عهود، ولن يروا منه الأماني التي كان يمنّيهم بها؛ لأنّ غرضه السلطة دون سواها، أملاً في أنّ ذلك سوف يفتح عيون الناس من جديد، ويندمون على ما قصّروا في نصرة إمامهم، ويرجعون للطاعة، فيتمكّن الإمام من حكمهم وفق شرع الله تارةً أُخرى؛ لذا لم يكن هناك تنازل دائم عن السلطة، بل كانت هناك هدنة بشروط معيّنة، تؤدّي بالنتيجة إلى عودة الخلافة لأصحابها.
ومن المهمّ أنْ نشير إلى أنّ الشروط التي ذكرها المؤرّخون فيها بعض الاختلاف، وفيها نقائص وزيادات، لذا سنشير مجملاً إلى بعض شروط الصلح ممّا ذكره أهل السير والتاريخ، ثمّ نقف بنوعٍ من التفصيل عند الشرط الذي يتعلّق بموضوع الخلافة بعد معاوية.
فقد ذكر الشيخ المفيد، بعض تلك الشـروط، وهي: «تركُ سبّ أمير المؤمنين×، والعدول عن القنوت عليه في الصلوات، وأن يُؤمن شيعته (رضي الله عنهم) ولا يتعرّض لأحدٍ منهم بسوء، ويوصل إلى كلّ ذي حقٍّ منهم حقّه[137].
وذكر ابن الأعثم وغيره أنّ الشروط هي:
1ـ أن يسلّم إلى معاوية الأمر، على أنْ يعمل فيهم بكتاب الله، وسنّة نبيه محمد’، وسيرة الخلفاء الصالحين.
2ـ وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد لأحدٍ من بعده عهداً، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين[138].
3ـ وعلى أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، في شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم.
4ـ وعلى أنّ أصحاب علي× وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم. وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه، وما أخذ الله على أحدٍ من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه.
5ـ وعلى أنّه لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين÷ ولا لأحدٍ من أهل بيت النبي’ غائلةً سرّاً وعلانية، ولا يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق[139].
وقد جمع الشيخ راضي آل ياسين شتات شروط الصلح من مصادره المختلفة وذكرها بشكل مواد، فكانت بالشكل التالي:
المادة الأُولى: تسليم الأمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب اللّه وبسنّة رسوله’، وبسيرة الخلفاء الصالحين.
المادة الثانية: أن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين×، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد.
المادة الثالثة: أنْ يترك سبَّ أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكر علياً إلّا بخير.
المادة الرابعة: استثناء ما في بيت مال الكوفة، وهو خمسة آلاف ألف، فلا يشمله تسليم الأمر، وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن× كلّ عام ألفي ألف درهم، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وأن يفرّق في أولاد مَن قُتل مع أمير المؤمنين× يوم الجمل وأولاد مَن قُتل معه بصفّين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد.
المادة الخامسة: على أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض اللّه، في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وأن يؤمّنَ الأسود والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتّبع أحداً بما مضـى، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنة[140].
وقفة مع الشرط المتعلّق بالخلافة
من الواضح أنّ المتأمّل في شروط الصلح أعلاه سيتّضح له أنّ الشـرط المتعلّق بالخلافة هو من أهمّ البنود التي حوتها وثيقة الصلح؛ إذ على أساسه يتعلّق مستقبل الخلافة الإسلامية، وفي ضوئه يتبيّن هل أنّ الإمام الحسن× تنازل عن الخلافة نهائيّاً أم لفترة مؤقتة فرضتها عليه ظروف المرحلة، ومن خلاله سيتّضح هل أنّ حركة الإمام الحسين× وقعت في سياق صلح الحسن، أم هي حركة لا تربطها بالصلح أيّة رابطة تذكر، لذا أفردنا دراسة لهذا الشـرط على حدة؛ لنرى حقيقة الأمر فيه.
فنقول: إنّ هذا الشرط وردت فيه صياغات متعدّدة، وهي بحسب ما تتبّعناه ووقفنا عليه ثلاث صيغ:
الصيغة الأُولى: أنْ ليس لمعاوية أنْ يعهد لأحدٍ من بعده، وأنّ الأمر من بعده شورى للمسلمين.
الصيغة الثانية: إنّ الخلافة من بعد معاوية تعود للإمام الحسن×.
الصيغة الثالثة: إنّ الخلافة من بعد معاوية تعود للإمام الحسن×، فإنْ حدث به حدث، تعود للإمام الحسين×.
هذه هي الصيغ التي وقفنا عليها في كتب السِّيَر والتاريخ، والمتعلّقة بمصير الخلافة بعد معاوية، فلا بد أنْ نضعها تحت طاولة البحث، فنقول:
وهي أنْ ليس لمعاوية أنْ يعهد لأحدٍ من بعده، وأنّ الأمر من بعده شورى للمسلمين.
وأهمّ المصادر التي وقفنا عليها، وقد نقلت هذه الصيغة هي: أنساب الأشراف للبلاذري[141]، والفتوح لابن الأعثم[142]، وشرح النهج لابن أبي الحديد نقلاً عن المدائني[143]. وكذلك أورد هذا الشرط محمّد بن طلحة الشافعي[144]، وابن حجر الهيتمي[145]، وابن الصبّاغ المالكي[146].
والملاحظ أنّ أقدم مصدر ذكر هذه الصيغة هو المدائني المتوفّى (225هـ)، ولم نقف على سندٍ لها، فهي مرسلة، والمصدر الثاني الذي ذكرها هو البلاذري المتوفّى (279هـ)، ولم يذكر سنده أيضاً، والمصدر الثالث هو ابن الأعثم المتوفى (314هـ) ومن دون سندٍ أيضاً، وربما اعتمد على سابقيه في ذلك، ثمّ نقلها بعض مَن جاء بعدهما، وغالب الظنّ أنّهم اعتمدوا على هؤلاء في نقلهم.
والخلاصة: إنّ هذه الصيغة لا تحضى بالقبول من الجهة السندية؛ لأنّها مرسلة، لم نقف لها على أي إسناد، ثمّ إنّه لو تنزّلنا عن مسألة الإسناد في القضايا والأحداث التاريخية، وقلنا بقبول حتى الروايات الضعيفة في التاريخ، فإنّ ذلك مشروط بعدم اختلاف النقل، وعدم وجود معارض لها. أمّا مع وجود المعارض كما هو حاصل؛ إذ إنّ الصيغة الثانية والثالثة تعارض الصيغة الأُولى بصورة صريحة؛ فلا بدّ حينئذٍ من ملاحظة أسانيد تلك الصيغ وإجراء المرجّحات لنتعرف على الصيغة الصحيحة، وسنعرف أنّ الصيغة الثانية بطرقها ومتنها أصحّ وأسلم من الأُولى، فانتظر.
وأمّا ما يتعلّق بالمتن، فمن الواضح أنّ الصيغة الأُولى تتعارض مع المبادئ التي يؤمن بها الإمام الحسن×، فهو يعتقد أنّ الخلافة له دون غيره، وأراد قتال معاوية على ذلك، فأجبرته الظروف على الصلح، فلا معنى أنْ يتنازل عن حقّه حتّى بعد موت معاوية! خصوصاً أنّ البلاذري يذكر كتاب معاوية إلى الحسن×، المتضمّن شروط الصلح، وينصّ فيه معاوية على أنّ الخلافة من بعده للحسن×[147]، لكن مع ذلك فإنّ الحسن يشترط في كتاب الصلح أنْ تكون الخلافة شورى بعد معاوية! ولعلّ هذا من العجائب التي لا يمكن تصديقها! أضف إلى ذلك فإنّ الحسن× يعتقد أنّ الخلافة أمر إلهي، وهي لأهل البيت^ دون غيرهم، ولا يعتقد بصحّة الشورى، فلإنْ ألجأته الظروف للتخلّي عن الحكومة السياسية لمعاوية في وقتٍ معيّن، فلا مبرّر للتنازل عنها مطلقاً. والمتأمّل في خُطبه وكذا مراسلاته مع معاوية، يجد أنّه يصرّح بما لا يقبل الشكّ بأنّ الخلافة لهم دون غيرهم، فلا معنى حينئذٍ أنْ تكون شروط الصلح بيده، ومع ذلك يتنازل عن حقّه بلا مبرر، ويشترطه أنْ يكون بعد معاوية شورى للمسلمين!
فقد نقل البلاذري والمدائني ـ واللفظ له ـ أنّ الإمام الحسن× خطب في الناس بعد وفاة والده×، فقال: «أيها الناس، اتقوا الله، فإنّا أمراؤكم وأولياؤكم، وإنّا أهل البيت الذين قال الله تعالى فينا: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)، فبايعه الناس[148].
وأخرج الطبراني بسندٍ رجاله ثقات[149]: إنّ الحسن× خطب في أهل العراق بعد أنْ طعنه أحدهم بخنجر، فقال: «يا أهل العراق اتقوا الله فينا فإنّا أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل البيت الذي قال الله (عزّ وجلّ): (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا). فما زال يومئذٍ يتكلّم حتى ما يُرى في المسجد إلّا باكياً[150].
وجاء في أحد كتبه إلى معاوية، كما نقله ابن الأعثم والمدائني ـ واللفظ للثاني ـ: «فلمّا توفاه الله ـ يعني النبيّ’ ـ تنازعت العرب في الأمر بعده، فقالت قريش: نحن عشيرته وأولياؤه، فلا تنازعونا سلطانه، فعرفت العرب لقريش ذلك، وجاحدتنا قريش ما عرفتْ لها العرب، فهيهات! ما أنصفتنا قريش، وقد كانوا ذوي فضيلة في الدين، وسابقة في الإسلام، ولا غرو إلّا منازعته (منازعتك) إيانا الأمر بغير حقّ في الدنيا معروف، ولا أثر في الإسلام محمود، فالله الموعد...[151].
وجاء في الخرائج: «ثمّ كتب جواباً لمعاوية: إنّما هذا الأمر لي والخلافة لي ولأهل بيتي، وإنّها لمحرمة عليك وعلى أهل بيتك، سمعته من رسول الله’، والله لو وجدت صابرين عارفين بحقّي غير منكرين ما سلّمت لك ولا أعطيتك ما تريد[152].
وروى الشيخ الصدوق بسنده عن أبي سعيد عقيصاً قال: «قلت للحسن بن علي بن أبي طالب÷: يا بن رسول الله، لِمَ داهنت معاوية وصالحته، وقد علمت أنّ الحقّ لك دونه، وأنّ معاوية ضالّ باغٍ؟
فقال: يا أبا سعيد! ألستُ حجّة الله (تعالى ذكره) على خلقه، وإماماً عليهم بعد أبي×؟ قلت: بلى. قال: ألستُ الذي قال رسول الله’ لي ولأخي: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت: بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذ لو قعدت، يا أبا سعيد علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة رسول الله’ لبني ضمرة وبني أشجع، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل، يا أبا سعيد، إذا كنت إماماً من قِبَل الله (تعالى ذكره) لم يجب أن يُسفّه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإنْ كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبساً[153].
فهذه جملة من النصوص الشيعية والسنية تثبت أنّ الإمام الحسن× يعتقد بأحقيّته في الخلافة.
فالصيغة الأُولى إذن تعاني من المشكلة السندية، ومعارضة الصيغتين الأُخريين، ومتنها لا يتوافق مع توجّهات الإمام الحسن×.
وهي أنّ الخلافة من بعد معاوية تعود للإمام الحسن×.
هذه الصيغة وردت بأسانيد معتبرة وصحيحة، وعليها أكثر المؤرّخين وأصحاب السير، بل ذكر ابن عبد البر عدم الخلاف فيها. نقف فيما يلي على بعض النصوص في ذلك:
قال ابن عبد البرّ: «ولا خلاف بين العلماء أنّ الحسن إنّما سلَّم الخلافة لمعاوية حياته لا غير، ثمّ تكون له من بعده، وعلى ذلك انعقد بينهما ما انعقد في ذلك، ورأى الحسن ذلك خيراً من إراقة الدماء في طلبها، وإنْ كان عند نفسه أحقّ بها[154].
قال ابن حجر العسقلاني: «وذكر محمّد بن قدامة في كتاب الخوارج، بسندٍ قوي إلى أبي بصرة أنّه سمع الحسن بن عليّ يقول في خطبته عند معاوية: إنّي اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده[155].
وأخرج ابن أبي خيثمة، قال: حدّثنا هارون بن معروف، حدّثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال: «لمّا قُتل عليّ سار الحسن بن عليّ في أهل العراق، ومعاوية في أهل الشام، فالتقوا، فكرِه الحسن القتال، وبايع معاوية على أنْ يجعل العهد للحسن من بعده، فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين. فيقول: العار خير من النار[156].
فالخبر الأول قوّاه ابن حجر كما عرفنا، والخبر الثاني رواته كلّهم ثقات، إذ إنّ ابن أبي خيثمة ـ وهو أحمد بن زهير ـ من الثقات المعروفين، رواه عن هارون بن معروف، وهو ثقةٌ أيضاً، وقد رواه عن ضمرة بن ربيعة، وهو ثقةٌ كذلك، وقد رواه عن عبد الله بن شوذب وهو ثقةٌ من العبّاد.
فالخبر صحيح كذلك، إلّا أنّ ابن شوذب لم يرَ الحسن×، فالخبر مرسل صحيح، وذلك غير ضارّ لأمرين:
الأوّل: إنّه يصلح أنْ يكون شاهداً قوياً على الخبر الآخر الذي قوّاه ابن حجر.
الثاني: إنّ عبد الله بن شوذب من الثقات العبّاد، وهو هنا ينقل قصّة عايشها آباؤه وأجداده وكبار مجتمعه؛ إذ إنّه من كبار أتباع التابعين، فمن المؤكّد أنّه أخذ تلك القصّة من مجتمع قد عاش تلك الفترة وعرف أحداثها، وأكثرهم من التابعين، فهو أخذ تلك التفاصيل واستقاها من مجتمع بأسره كان يتداولها ويتناقلها، فليس الموضوع عبارة عن رواية قد يكون تفرّد بها راوٍ معيّن فيكون الإرسال مضرّاً بها، بل إنّما نتحدّث عن أهمّ حدث تاريخي كان في تلك الفترة وهو صلح بين أكبر قوتين، وأكبر حاكمين على الأرض في وقتهما، فلا شكّ أنّها كانت معروفة بتفاصيلها في تلك الفترة، فإرسال ابن شوذب لها لوضوحها ومعرفتها في تلك الأوساط؛ ولذا فإنّ ابن شوذب يتبنّى ذلك الموقف وينقله بنحو الأمر المسلّم المقطوع به.
ونضيف أيضاً: إنّ هذا الشرط قال به أحمد بن حنبل، فعن صالح بن أحمد بن حنبل، قال: «سمعت أبي يقول: بايع الحسنَ تسعون ألفاً، فزهد في الخلافة وصالح معاوية، ببذله له تسليم الأمر على أنْ تكون الخلافة له بعده، وعلى أنْ لا يُطلَب أحد من أهل المدينة والحجاز والعراق بشيء ممّا كان من أيّام أبيه، وغير ذلك[157].
ونقل ابن حجر قولَ ابن سعد: «وأخبرنا عبد الله بن بكر السهمي، حدّثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، قال: وكان معاوية يعلم أنّ الحسن أكره الناس للفتنة، فراسله وأصلح الذي بينهما، وأعطاه عهداً: إنْ حدث به حدث والحسن حيّ ليجعلنّ هذا الأمر إليه[158].
وهذا السند صحيح، رجاله ثقات، غير أنّ عمرو بن دينار لم يدرك أحداث تلك الفترة؛ إذ إنّ ولادته في حدود سنة 46 للهجرة، فخبره صحيح مرسل، لكنّه كسابقه شاهد قويّ على صحّة هذا الشرط.
وفي الإمامة والسياسة: «فاصطلح معه على أنّ لمعاوية الإمامة ما كان حيّاً، فإذا مات فالأمر للحسن[159].
وذكر السيوطي أنّ الحسن× بذل لمعاوية تسليم الأمر على أنْ تكون الخلافة له من بعده[160].
وفي أنساب البلاذري: أنّ معاوية كتب إلى الحسن×: «إنّي صالحتك على أنّ لك الأمر من بعدي. وكذلك يذكر أنّ معاوية دفع إلى الحسن صحيفة بيضاء وقد ختم في أسفلها، وقال له: «اكتب فِيهَا مَا شئت. لكنّه يذكر بعد ذلك تناقضاً يصعب القبول به، وهو أنّ الحسن× اشترط أنْ يكون الأمر شورى بعد معاوية[161]. وهو أمر في غاية الغرابة، ويتنافى مع كلّ مبادئ الحسن×، فمعاوية بنفسه يعطيه الخلافة من بعده، لكن الحسن× يرفض ذلك ويجعلها شورى!
وذكر ابن حجر الهيتمي هذا الشرط أيضاً، وأنّ الخلافة للإمام الحسن× من بعد معاوية، وأنّ معاوية فوّض الإمام الحسن× في كتابة الشروط، وبعث إليه برقٍّ أبيض، وقال: اُكتب ما شئت فيه، فأنا ألتزمه، وقال بعده: «كذا في كتب السِّيَر، أي أنّ ابن حجر اعتمد في ذلك على عدّة كتب في السير، كلها ذكرت هذا الشرط، والتفويض من معاوية للإمام الحسن× في كتابة ما يشاء من الشروط، ثمّ إنّ ابن حجر ذكر ما في صحيح البخاري عن الحسن البصري من أنّ معاوية أرسل رجلين إلى الحسن يطلب منه الصلح والهدنة، «فما سألهما شيئاًإلّا قالا: نحن لك به؛ فصالحه، لكنّ ابن حجر يعود ويذكر كتاب الصلح، فيذكر أنّ الشرط هو أنْ تكون الخلافة بعد معاوية شورى بين المسلمين[162].
وهو تهافتٌ واضح وصريح، لا ينسجم مع ما ذكره من اشتراط الإمام الحسن× أنْ تكون الخلافة له، ولا مع المجريات والأحداث التي ذكرها ابن حجر نفسه.
وذكر هذا الشرط أيضاً، البري في الجوهرة في نسب الإمام علي×[163].
فاتّضح إذاً أنّ ابن عبد البر ذكر عدم خلاف العلماء على هذا الشرط، وذكره ابن حجر من كتاب ابن قدامة وقوّى سنده، وأخرجه ابن أبي خيثمة بسند صحيح مرسل، وأخرجه ابن سعد بسند صحيح مرسل، وبه قال أحمد بن حنبل، والبرّي، وابن قتيبة، واضطربت عبارات البلاذري والهيتمي فيه.
وإذا ما عرفنا أنّ هذا الشرط ينسجم تماماً مع اعتقاد الإمام الحسن× في أنّ الإمامة مختصّة بأهل البيت^ حصراً، وأنّ الخلافة بعد عليّ هي له، وليست لمعاوية بأيّ وجهٍ من الوجوه، اتّضح أنّ هذا الشرط هو الأولى بالقبول والاعتماد، فهو مقدّم متناً وسنداً على الشرط الأوّل.
وقفة مع الدكتور محمّد عبد الهادي الشيباني
من الواضح أنّ اشتراط الإمام الحسن× في وثيقة الصلح أنْ تكون الخلافة له بعد موت معاوية تعني بطلان خلافة يزيد، وعودة الخلافة إلى أهل البيت^، وهذا ما يبرّر للإمام الحسين× التحرّك؛ باعتبار أنّ الخلافة مغتصبة، وهذا الأمر لا يعجب بعض الأقلام التي تنطلق من موقف عقائدي مسبق، ولا تريد أنْ تقرأ التأريخ بتجرّد وتأنّي، لتصل من خلاله إلى حقائق، بل يقرأُونه ليسقطوه على عقيدتهم القبلية؛ لذا فمن المؤسف ما نراه ممَّا تُسمّى برسائل علمية، وهي لا تمتّ للعلم بصلة، بل هدفها دفاع عن عقيدةٍ مسبقة، ولو لزم ذلك ليّ أعناق الروايات والأخبار، فنلاحظ أنّ الدكتور محمّد عبد الهادي الشيباني في رسالته المدافعة عن يزيد، والتي تحمل عنوان: (مواقف المعارضة في عهد يزيد) يتعرّض لشروط الصلح، ويذكر قول ابن عبد البرّ في عدم خلاف العلماء في هذا الشرط، ويذكر الروايات الصحيحة والمعتبرة على هذا الشـرط، ويشير إلى أنّ هناك طرقا أُخرى لم تشترط هذا الشـرط، لكنّه سرعان ما يتنكّر لما نقله، ويتبنّى عدم اشتراط الإمام× لذلك، بلا أدلّة علمية، متجاهلاً في ذلك أقوال الإمام الحسن× في أحقيّته بالخلافة، وضارباً عرض الجدار قول ابن عبد البر والأخبار الصحيحة في ذلك، بدعوى تُضحك الثكلى، فاعتبر كلام عبد البر وإطلاقه التعميم وهماً لا أكثر؛ لأنّه اعتمد في دعواه على تلك الروايات فقط!
وهذا تسفيه منه لعالمٍ كبير مثل ابن عبد البر، فكيف يُطلق هكذا دعوى جزافاً استناداً إلى بعض الأخبار! ومن دون أنْ تكون بين يديه أقوال العلماء في ذلك.
ثمّ إنّه اعتبر تلك الأخبار ـ والتي قال بصحّتها ـ أنّها مجرد إشاعات أطلقها أنصار العلويين، مستنداً في ذلك إلى رواية جبير بن نفير، قال: «إنّ الناس يزعمون أنّك تريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون مَن سالمت، ويحاربون مَن حاربت، فتركتها ابتغاء وجه الله، ثمّ أبتزّها بأتياس أهل الحجاز[164].
وليت المؤلّف يخبرنا كيف أنّ جماجم العرب كانت بيده، ولماذا صالح الإمام× بعد ما سار بجيشه للقتال في بادئ الأمر؟ ويبدو أنّ المؤّلف أخذته العصبية فنسي ما قاله قبل ذلك؛ حيث ذكر أنّ جيش الإمام الحسن×، كان متفرّقاً متخاذلاً، همّه السلب والنهب، فقد ذكر في الصفحات (135 إلى 137) حوادث ما جرى في جيش الإمام الحسن×، وأنّه نادى منادٍ: إنّ قيس بن سعد قائد الجيش قد قُتل، فانتُهبت سرادق الحسن× حتى نازعوه بساطاً تحته، وطعنه رجلٌ من الخوارج في وركه طعنةً خطيرة، ثمّ قال: «فغالب الجند كانوا من الأعراب الذين لم يتغلغل في قلوبهم الإيمان، وإنّما هدفهم الوحيد هو النهب والسلب والقتل، فليسوا بأهل مبادئٍ وأهدافٍ سامية... ومن المعلوم أنّ أيّ جيش تسيطر عليه روح السّلب والنهب، وليس لدى أفراده الامتثال والطاعة للقائد؛ فمن المستحيل تحقيق أي انتصار بهذا الجيش.
إذاً؛ الدكتور بنفسه يتبنّى أنّ جيش الإمام الحسن× كان مفكّكاً، ومن المستحيل تحقيق أي انتصار به، فليخبرنا إذاً هل كان الحسن بيده جماجم العرب، أو بيده جيش تسيطر عليه روح السلب والنهب[165]؟! فما هذا التناقض الذي نراه في صفحات متقاربة، أفهل نسـي المؤلف ما قاله، أو أنّ اشتراط الخلافة تُطيح برسالته من الأساس، وتُثبت أنّ يزيد تسلّم الخلافة بصورة غير شرعية، فهو باغٍ مدّعٍ ما لم يستحقّ، ومتسلّط على المسلمين بغير وجه حقٍّ؟! ثمّ لو فرضنا أنّ رواية جبير صحيحة متناً وسنداً، فهي تتعارض مع عدّة أخبار ـ بينها الصحيح أيضاً ـ تدلّ على اشتراط الخلافة للحسن! فبأيّ وجهٍ جمع الأستاذ بين الروايات؟! ولماذا تغافل خطابات الإمام الحسن× ونصوصه المؤكّدة على أولويته في الخلافة، والتي بطبيعة الحال ترجّح الاشتراط دون غيره؟!
ولعلّ الأغرب من ذلك أنّه ذكر رواية لا تذكر شروط الصلح أبداً، بل تشير إلى أنّ هناك شروطاً ما، وخرج منها بنتيجة أنّ الإمام الحسن× لم يشترط!
قال: ولكنّنا نستطيع أنْ نؤلّف بين ذلك الخلاف (يعني الخلاف في الاشتراط وعدمه) من خلال الرواية التي ذكرها الحافظ ابن حجر: «أخرج يعقوب بن سفيان، بسندٍ صحيح إلى الزهري، قال: كاتَبَ الحسن بن علي معاوية، واشترط لنفسه، فوصلت الصحيفة لمعاوية، وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح، ومع الرسول صحيفةٌ بيضاء مختومٌ على أسفلها، وكتب إليه أن اشترط ما شئت فهو لك، فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أوّلاً، فلمّا التقيا وبايعه الحسن، سأله أن يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله؛ فتمسّك معاوية إلّا ما كان الحسن سأله أوّلاً، واحتجّ بأنّه أجاب سؤاله أوّل ما وقف عليه، فاختلفا في ذلك، فلم ينفّذ للحسن من الشرطين شيء[166].
وهذه الرواية تؤكّد أنّ للحسن شروطاً معيّنة في بادئ الأمر، ثمّ وصلته صحيفة بيضاء مختومة من معاوية، يخوّل فيها الحسن اشتراط ما شاء، فاشترط الامام× أضعاف ما كان شرطه أوّلاً، ثمّ تنصّل معاوية من ذلك، واختلفا ولم يفِ له بشيء. فهل تجد عزيزي القارئ أنّ الخبر يدل على عدم اشتراط الإمام الحسن× للخلافة من بعد معاوية، فالمؤلّف ـ ما شاء الله عليه ـ خرج من هذه الرواية بنتيجة يعجز كلّ خرِّيتي الفن أنْ يفهموها، فقال بعد الخبر بلا فاصل يُذكر ما نصّه: «وبهذا يتبيّن أنّ مسالة خلافة الحسن بعد معاوية لم تكن ضمن الشـروط، وربّما أشيعت بقصد تلافي ردّة الفعل عند أتباعه، تهدئة لنفوسهم[167].
ونترك التعليق للقارئ؛ ليرى بنفسه كيف أنّ الحقيقة تُحرّف، وكيف أنّ النصوص تؤوَّل، بل إنّ النتائج تُكتب بمعزل عمّا تدلّ عليه الأخبار؛ لأنّها مسلّمة مسبقاً.
وكما أشرنا سابقاً، فإنّ المؤلّف اضطرّ إلى رفض هذا الشـرط؛ لأنّه يطيح بمشروعية خلافة يزيد، ويُعطي المشروعية لثورة الحسين×، وهذا ما أشار إليه المؤلّف نفسه حين قال ـ وهو يؤكّد نفي هذا الشرط ـ: «فلو كان الأمر كما تذكر الروايات عن ولاية عهد الحسن بعد معاوية، لاتخذها الحسين بن علي حجّة، وقال: أنا أحقّ بالخلافة، ولكن لم نسمع شيئاً من ذلك على الإطلاق[168].
فالمؤلّف ـ إذاً ـ ملتفت جيّداً إلى أنّ هذا الاشتراط يعطي الحجيّة للإمام الحسين× في التحرّك، ويسلب شرعية يزيد؛ لذا سعى لإنكاره بلا وجوه علمية تُذكر، مؤيّداً كلامه باستبعاد أنْ يكون الشـرط موجوداً، ولم يستخدمه الإمام الحسين× في الاحتجاج به.
لكنّ استبعاده هذا غير صحيح؛ لعدّة أُمور:
أوّلاً: لو فرضنا ـ جدلاً ـ عدم وصول احتجاج من الإمام الحسين× بخلافته وإمامته، فذاك لا يعني عدم احتجاجه اقعاً بها؛ لأنّ التاريخ لم يصلنا بتمامه وكماله، وقد كُتب بأيدي موافقة للخط الأُموي، ومخالفة لنهج أهل البيت×، فلا نتوقّع أنْ يصل فيه كلّ ما حصل وحدث، فقد يكون الحسين× احتجّ بهذا الشرط وادعّى الخلافة ولم يصل إلينا، فلا يمكن أنْ نسقط الأخبار الصحيحة المؤكّدة لحصول الشـرط في قبال أمر احتمالي، فعدم وصول الاحتجاج لا يساوق عدم الاحتجاج واقعاً، فيبقى الأمر محتملاً لا يمكننا أنْ نتمسّك به، ولا نستطيع نفيه في الواقع، فتبقى الأخبار الصحيحة حجّة علينا في قراءة التاريخ والتعامل معه.
ثانياً: نحن لا نسلّم أنّه لم يصل شيء من ذلك كما ادّعى المؤلّف، فسيأتي في الصيغة الثالثة أنّ الإمام الحسين× احتجّ في عدم مبايعته ليزيد باشتراط الإمام الحسن× الخلافة له ثمّ للحسين× من بعده.
ثالثاً: سيأتي متفرّقاً في البحث عدّة خطابات للإمام الحسين× تؤكّد أنّ الخلافة له، فهذه الخطب وإنْ لم تتعرّض للشـرط، لكنّها تصـرّح بجوهر الموضوع، وهي أنّ الخلافة للحسين× في وقته.
فتحصّل أنّ اشتراط الإمام الحسن× أنْ تكون الخلافة له ثابت بالأخبار الصحيحة، ومحاولة الدكتور المذكور إنكار ذلك هي محاولة بائسة، هدفها إضفاء الشرعية على خلافة يزيد ليس إلّا.
إنّ للإمام الحسن× ولايةَ الأمر من بعد معاوية، فإنْ حدث به حدث فللحسين×.
وهذا الشرط لم نعثر عليه، إلّا في مصدرين فقط، وهما عمدة الطالب لابن عنبه، حيث جاء فيه: «وشرط عليه شروطاً إنْ هو أجابه إليها سلّم إليه الأمر، منها أنّ له ولاية الأمر بعده، فإن ْحدث به حدث فللحسين[169].
والفتوح لابن الأعثم، حينما ذكر كلاماً للإمام الحسين× مع ابن الزبير ورد فيه هذا الشرط، فقد جاء في الفتوح: «فقال له ابن الزبير: فاعلم يا بن علي أنّ ذلك كذلك، فما ترى أن تصنع إن دُعيت إلى بيعة يزيد ـ أبا عبد الله ـ ؟ قال: أصنع أنّي لا أُبايع له أبداً؛ لأنّ الأمر إنّما كان لي من بعد أخي الحسن×، فصنع معاوية ما صنع، وحلف لأخي الحسن أنّه لا يجعل الخلافة لأحدٍ من بعده من ولده، وأنْ يردّها إليّ إنْ كنتُ حيّاً، فإنْ كان معاوية قد خرج من دنياه ولم يفئ لي ولا لأخي الحسن بما كان ضمن، فقد والله أتانا ما لا قوام لنا به، اُنظر ـ أبا بكر ـ أنّى أُبايع ليزيد! ويزيد رجل فاسق، معلن الفسق، يشرب الخمر، ويلعب بالكلاب والفهود، ويبغض بقية آل الرسول!! لا والله لا يكون ذلك أبداً[170].
وعند التأمّل؛ فإنّ هذا الشرط يتنافى مع الصيغة الأولى، لكنّه لا يتنافى مع الصيغة الثانية، إذ يمكن الجمع بين الاثنين بأنْ تكون الخلافة للحسن×، فإنْ تُوفّي فللحسين×، كما أنّ هذا الشرط يتناسب تماماً مع المبادئ والعقائد التي يؤمن بها الحسن×، فهو يؤمن بأنّ الإمامة في أهل البيت^ كما أشرنا، فكان من الطبيعي أنْ يشترط عودتها للمسار الذي أراده الله، وهو كون الخلافة بعد الحسن للإمام الحسين×، هذا بحسب النصّ الإلهي الذي يؤمن به الإمام×، ولو تنزّلنا عن ذلك، فإنّ الخلافة للإمام الحسين× أيضاً، وذلك من جهة المكانة والمقام الذي يحضى به الإمام الحسين×، فإذا ما عرفنا أنّ الشروط كانت بيد الحسن× يكتب ما يشاء، كان طبيعياً أنْ يشترط كون الخلافة من بعده للإمام الحسين×.
فاتّضح أنّ الذي يتناسب مع موقف الإمام الحسن×، والمؤيدّ من قبل نصوص تاريخية أيضاً أنّ شرط الإمام الحسن× على معاوية هو عودة الخلافة إليه، ومن بعده للإمام الحسين×.
مشروعية عقد المعاهدة بين طرفين شرعي وآخر غير شرعي
كلّ معاهدة لو أُريد لأطرافها الإلتزام، ومن ثمّ مؤاخذة الناكث، لا بدّ أنْ تكون صحيحة ومؤطّرة بأُطر شرعية أو قانونية يؤمن بها الفريقان، فالهدنة في مجتمع إسلامي، يرفع حكّامه شعار الإسلام لا بدّ أنْ تستمدّ مشـروعيتها، من الإسلام، والهدنة في مجتمع مدني لا يؤمن بقوانين الإسلام، لا بدّ أنْ تستمدّ مشروعيتها من القانون الذي يؤمنون به.
وإذا ما رجعنا إلى عصـر الإمام الحسن× ومعاوية، فلا شكّ أنّ الشعار الإسلامي هو المرفوع آنذاك، بل إنّ الخلاف هو في خلافة الأمّة الإسلامية، وحيث إنّ الإمام الحسن×، ومَن يعتقد بإمامته يرى بطلان حكم معاوية، وإنّه باغٍ متخلّف عن بيعة إمام زمانه وشاقٍّ لعصا المسلمين، وبالنتيجة فهو لا يحمل المشروعية في حكمه وخلافته، فحينئذٍ قد يُطرح السؤال التالي وهو:
إذا كانت خلافة معاوية ليست شرعية، فكيف يمكن إقامة هدنة مع طرف غير مشروع، وما هي الأطر الشرعية لهذه الهدنة؟
وفي الحقيقة أنّ تأمّلاً بسيطاً في سياسة النبيّ’ وسيرته يعطيك جواباً شافياً على هذا التساؤل، فالنبيّ حينما كان قائداً وحاكماً للإمّة الإسلامية، كان هو الذي يرسم السياسات ويشخّص المصالح التي تصب في خدمة الأُمّة الإسلامية والمفاسد التي تحيط بها، كما أنّ قوله وفعله وتقريره يمثل الشـرع الإلهي، ويكفينا حينئذٍ أنْ نعرف أنّ النبيّ’ أقام هدنة مع المشركين مع أنّه لا يعتقد بشرعيتهم، ففي الحديبية مثلاً حين منع المشـركون النبيّ’ وقومه من دخول البيت للاعتمار، رأى النبيّ’ أنّ المصلحة الإسلامية تقتضي الصلح مع المشركين، وفق شروط معيّنة، ومن هذه الشـروط: أنّ مَن يأتي إلى النبيّ يردّه إليهم، ومَن يأتيه منهم لا يردّونه إليه: «فاشترطوا على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) إنّ مَن جاء منكم لم نردّه عليكم، ومَن جاءكم منّا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنّه من ذهب منّا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً[171].
وقد ولّد هذا الصلح ريبة وشكّاً عند بعض الصحابة، وعلى رأسهم عمر بن الخطاب، حيث قال حينها: «يا رسول الله، ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيمَ نعطى الدنية في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟! فقال: يا بن الخطاب، إنّى رسول الله ولن يضيعني الله أبداً. قال: فانطلق عمر فلم يصبر متغيّظا، فأتى أبا بكر، فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حقّ وهم على باطل؟ قال: بلى. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلامَ نُعطى الدنية في ديننا، ونرجع ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا بن الخطاب، إنّه رسول الله، ولن يضيّعه الله أبداً[172].
وفي صحيح ابن حبّان وغيره، أنّه قال: «والله، ما شككت منذ أسلمت إلّا يومئذٍ[173].
بل إنّ الصحابة لم يستوعبوا الموقف، فبعد أنْ تمّ كتابة الكتاب، قال رسول الله لأصحابه: «قوموا فانحروا ثمّ أحلقوا، قال: فوالله، ما قام منهم رجل حتّى قال ذلك ثلاث مرات، فلمّا لم يقم منهم أحد، دخل على أُمّ سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس...[174].
والغرض أنّ النبيّ’ أقام الصلح، ولم يكترث بمخالفة الصحابة وامتعاضهم من ذلك؛ لأنّه أدرى وأعرف بالمصلحة منهم، وأنّ الصلح جائز حتى لو كان فيه بعض الأضرار، مادامت هناك مصلحة عُليا فيه؛ ولذا فإنّ الشوكاني يذكر عدّة استنتاجات من هذا الصلح، منها: «إنّ مصالحة العدو ـ ببعض ما فيه ضيم على المسلمين ـ جائزة للحاجة والضرورة، دفعاً لمحذور أعظم منه[175].
وحينئذٍ؛ فإنّ الإمام الحسن× هو الخليفة الشرعي في وقته، وهو المسؤول عن رسم سياسات الأُمّة، فلمّا رأى أنّ المصلحة تتطلّب إقامة الصلح، وإنّ استمرار القتال سيؤدّي إلى قتله وقتل الثلّة المخلّصة من أتباعه، من دون أنْ يكون لذلك أثر يُذكر؛ وافق على الصلح ضمن شروط تعيد الحقّ إليه، وتفضح سياسة معاوية وتكشف حقيقة أمره.
فالصلح يكتسب المشروعية من جهة أنّ الخليفة والحاكم هو المسؤول عن رسم سياسات الأُمّة، ويقوم بما تمليه عليه المصالح والمفاسد، وتأسّياً بما عمله الرسول’ مع المشركين في وقته.
وقد سبقه إلى الهدنة أبوه عليّ×، حينما اضطرّته الظروف للقبول بمهزلة التحكيم ووقْف القتال، فبعد أنْ التزم ذلك ورضي به، رفض العودة لقتال أهل الشام، مادام التحكيم لم يقع بعد، ولم تتّضح صورته.
وقد أعاد التأريخ نفسه، فاضطر الإمام الحسن× لعقد الصلح وسط رفض بعض أصحابه، وامتعاضهم من ذلك، وقد بيّن لهم الإمام الحسن× أنّ ذلك من أجل الحفاظ عليهم، وأنّ المصلحة تقتضي ذلك، بل واستشهد في بعض أجوبته بصلح النبيّ’، ونحن هنا ننقل صورة واحدة من ذلك توخيّاً للاختصار، فقد روى الشيخ الصدوق عن أبي سعيد عقيصا، قال: «قلت للحسن بن علي بن أبي طالب: يا بن رسول الله، لمَ داهنت معاوية وصالحته، وقد علمت أنّ الحقّ لك دونه، وأنّ معاوية ضالٌّ باغٍ؟ فقال: يا أبا سعيد، ألستُ حجّة الله (تعالى ذكره) على خلقه، وإماماً عليهم بعد[176] أبي×؟ قلت: بلى. قال: ألست الذي قال رسول الله’ لي ولأخي: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت: بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذ لو قعدت، يا أبا سعيد، علّة مصالحتي لمعاوية علّة مصالحة رسول الله’ لبني ضمرة وبني أشجع، ولأهل مكة حين انصـرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل، يا أبا سعيد، إذا كنت إماماً من قبل الله (تعالى ذكره) لم يجب أن يُسفّه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبساً، ألا ترى الخضر× لمّا خرق السفينة، وقتل الغلام، وأقام الجدار سخط موسى× فعله؛ لاشتباه وجه الحكمة عليه، حتى أخبره فرضي، هكذا أنا، سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما تُرك من شيعتنا على وجه الأرض أحدٌ إلّا قُتل[177].
هل تنازل الإمام الحسن× عن إمامته؟
إلّا أنّه قد يُقال: إنّ الإمامة إذا كانت بالنصّ الشـرعي، وأنّها مختصّة بأهل البيت^، فكيف جاز للإمام× التنازل عن حقّ أوكله الله به؟
والجواب: هذا خلط بين الإمامة الثابتة بالنصّ، وبين الخلافة السياسية التي هي أحد وظائف الإمام×، فأهل السنّة يعدّون الإمامة والخلافة السياسية شيئاً واحداً، بمعنى أنّ الإمام عندهم إنّما هو الخليفة السياسي، فيرون أنّ التنازل عن الخلافة السياسية هو تنازل عن الإمامة، وهو يتنافى مع كونها أمراً إلهياً، لا دخل للبشر في تحديدها وتعيينها.
لكنّ الإمامة عند الشيعة تمتلك مفهوماً أوسع، فالإمام مسؤول عن حفظ الشريعة، وإليه تكون مرجعية الأُمّة في شؤونها الفكرية والثقافية، ومنه تستقي الأحكام والعقائد وكلّ ما يمتّ للشـريعة بصلة، كما أنّه المسؤول عن بيان القرآن وأحكامه. وهكذا. فالإمامة هي امتداد لمنصب النبوة، وغير مختصّة بالخلافة السياسية، لكنّ الخلافة السياسية كما كانت إحدى وظائف الرسول’، فكذلك هي إحدى وظائف الإمام×.
ومنه يتّضح أنّ الإمام× لم يتنازل عن الإمامة، بل الإمامة ثابتة له بالنص، والناس كانت ترجع إليه وتسأله، وتستقي منه معارفها، لكنّه تنازل عن أحد وظائفه المتعلّقة بطاعة الأُمّة له؛ إذ لا يمكن تطبيق الحكومة مع كون الجماهير رافضة لذلك، وميّالة للباطل، ولم يكن يمتلك العدّة الكافية للدخول في قتال يفضي إلى النصر، ولو آجلاً، بل إنّ القتال لو حصل لأفضى إلى قتله وقتل أخيه، وقتل الثلّة الصالحة من أتباعه؛ لذا قبل بالصلح وتنازل مؤقّتاً عن منصب الخلافة السياسية لا غير، ولم يتنازل عن الإمامة.
وقد يحاول البعض أنْ يصوّر أنّ ما جرى هو تنازل من الإمام الحسن× عن الخلافة ليس إلّا، فليس له حق الرجوع به لاحقاً، وهذا الأمر غير صحيح بالمرّة، فإنّ التنازل الذي جرى إنّما هو بناءً على صلح وهدنة، ضمن شروط معيّنة، ولم يكن تنازلاً محضاً عن الخلافة فحسب، وغير متعلّق ولا مرتبط بأيّ أمرٍ آخر؛ ولذلك كُتبت وثيقة الصلح بين الفريقين، وتضمنّت عدّة شروط، ووقّع عليها الشهود، فلو كان الموضوع عبارة عن تنازل محض لا يمكن الرجوع فيه، فلا معنى حينئذٍ لكلّ ما كتبوه، ولا معنى لحضور الشهود، ولا معنى للبنود التي تضمّنتها الوثيقة، فإنّ كلّ ذلك يوضّح: إنّ ما جرى كان عبارة عن معاهدة ووثيقة بين الطرفين تكون ملزمة لهما طبق ما توافقوا عليه بها.
هذا ما يتعلّق بمشروعية الهدنة في جانبها الشـرعي، أمّا لو أردنا إخضاع الهدنة إلى الجانب القانوني، بمعنى إسقاط الوضع القانوني القائم على هكذا هدنة، فمن الواضح أيضاً أنّها تستمدّ المشـروعية وفق قوانين الأُمم المتحدة، وغيرها من القوانين المعروفة، ولا أدلّ على ذلك ممّا نشاهده اليوم من اتفاقيات ومفاوضات بين الطرف الشرعي والطرف الآخر، سواء كان محتلاً أو متمرّداً. فكثيراً ما نرى الحكومات تعقد هدنة مع المتمرّدين لوقف القتال فترة معيّنة، أو لتشكيل حكومة أُخرى وفق انتخابات ضمن شرائط خاصّة، ولا نريد أنْ ندخل بذكر أمثلة، أو نقول إنّ المفاوضات لها شرعية معيّنة، بل الغرض أنّ القوانين الوضعية القائمة هذا اليوم تُقرّ المفاوضات والاتفاقيات بين الأطراف المختلفة، ولو كان أحدها يمثل الشرعية والآخر عدمها، ومن ثَمّ ترتّب الآثار على الطرف غير الملتزم بتلك الاتفاقية.
على أنّه لو قلنا إنّ الهدنة بين طرف شرعي وآخر غير شرعي ليس لها ما يسوّغها قانوناً، فهذا يعني بطلانها وعدم ترتّب الأثر عليها، وهو يعني قانونية خلافة الإمام الحسن×، وبطلان خلافة معاوية وفق القانون الوضعي أيضاً.
الظاهر أنّ هناك شبه إجماع من علماء التاريخ والسير على أنّ معاوية نكث العهد والميثاق، ولم يلتزم بتلك الاتفاقية، وأخلّ بشروطها:
قال ابن حجر: «وأخرج يعقوب بن سفيان بسندٍ صحيح إلى الزهري، قال: كاتب الحسن
ابن عليّ معاوية واشترط لنفسه، فوصلت الصحيفة لمعاوية، وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح، ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها، وكتب إليه أن اشترط ما شئت فهو لك، فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أولاً، فلمّا التقيا وبايعه الحسن سأله أنْ يعطيه ما اشترط في السجل الذي ختم معاوية في أسفله، فتمسّك معاوية إلّا ما كان الحسن سأله أولاً، واحتجّ بأنّه أجاب سؤاله أوّل ما وقف عليه، فاختلفا في ذلك، فلم ينفّذ للحسن من الشرطين شيء[178].
وأخرج ابن أبي شيبة، قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن سعيد بن سويد قال: «صلّى بنا معاوية الجمعة بالنخيلة في الضحى، ثمّ خطبنا، فقال: ما قاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا، وقد أعرف أنّكم تفعلون ذلك، ولكن إنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك، وأنتم له كارهون[179].
وفي أنساب الأشراف للبلاذري: «قالوا: ثمّ قام معاوية فخطب الناس، فقال في خطبته: ألا إنّي كنت شرطت في الفتنة شروطاً، أردت بها الأُلفة، ووضع الحرب، ألا وإنّها تحت قدمي![180].
وروى أبو الحسن المدائني، قال: «خرج على معاوية قومٌ من الخوارج بعد دخوله الكوفة وصلح الحسن× له، فأرسل معاوية إلى الحسن× يسأله أن يخرج فيقاتل الخوارج، فقال الحسن: سبحان الله! تركت قتالك وهو لي حلال لصلاح الأُمّة، وأُلفتهم، أفتراني أُقاتل معك! فخطب معاوية أهل الكوفة، فقال: يا أهل الكوفة، أتروني قاتلتُكم على الصلاة والزكاة والحجّ، وقد علمتُ أنّكم تصلّون وتُزكّون وتحجّون، ولكنّني قاتلتكم لأتأمّر عليكم وعلى رقابكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارهون، ألا إنّ كلّ مالٍ أو دمٍ أُصيب في هذه الفتنة فمطلول، وكلّ شرط شرطته فتحت قدميّ هاتين[181].
وأمّا أبو إسحاق السبيعي، فقال: «إنّ معاوية قال في خطبته بالنخيلة: ألا إنّ كلّ شيء أعطيته الحسن بن علي تحت قدميّ هاتين لا أفي به.
قال أبو إسحاق: «وكان والله غدّاراً[182].
قال أبو الحسن: وكان الحصين بن المنذر الرقاشي يقول: «والله، ما وفى معاوية للحسن بشيء ممّا أعطاه، قتل حجراً وأصحاب حجر، وبايع لابنه يزيد، وسمّ الحسن[183].
فما ذكرناه يبيّن أنّ معاوية كان هدفه الملك والسلطان، ولم يفِ للإمام الحسن× بأيّ شرط. وهناك مصادر لم تذكر التعميم، بل ذكرت بعض الشروط التي لم يفِ بها معاوية، من قبيل عدم سبّ أمير المؤمنين×، وتسليم خراج دار أبجرد، فقد قال ابن الأثير، وبنحوه أبو الفداء: «وكان الذي طلب الحسن من معاوية أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة، ومبلغه خمسة آلاف، وخراج دار أبجرد من فارس، وأن لا يشتم عليّا، فلم يجبه إلى الكفّ عن شتم علي، فطلب أنْ لا يُشتم وهو يسمع فأجابه إلى ذلك، ثمّ لم يفِ له به أيضاً، وأمّا خراج دارأبجرد فإنّ أهل البصـرة منعوه منه، وقالوا: هو فيؤنا، لا نعطيه أحداً. وكان منعُهُم بأمر معاوية أيضاً[184].
ويكفي في عدم تطبيق معاوية لشروط الصلح أنّه جعل الخلافة من بعده في ابنه يزيد، وقد عرفنا أنّ المصادر اتّفقت على عدم حقّ معاوية في ذلك؛ إذ حسب ما ذكرنا فإنّ الشـرط إمّا عودة الخلافة للإمام الحسن× أو أنْ تكون شورى، وعلى كلا التقديرين فإنّ معاوية لم يفِ بذلك.
الأثر المترتّب على مخالفة الهدنة شرعاً وقانوناً
عرفنا فيما تقدّم أنّ الخلافة بعد عثمان كانت لعليّ×، وقد أعلن معاوية عدم خضوعه، واستقلّ بخلافة الشام، وقد دعاه الإمام× للطاعة فلم ينفع، ثمّ كانت صفّين وما آلت إليه من مهزلة التحكيم، وغدر ابن العاص بأبي موسى، وتفكّك جيش الإمام× وتكاسلهم عن الجهاد بعد ذلك، ثمّ بُويع للإمام الحسن× وأراد قتال معاوية مجدّداً؛ لاستمراره بالخروج عن الشـرعية، وعدم خضوعه للخلافة المنتخبة، لكنّ ميول الناس للدِّعة والراحة، ومكر معاوية حال دون ذلك، فكان الصلح والهدنة ضمن شروط تُمكِّن الإمام الحسن× من أنْ يُعيد الخلافة إلى مسارها الصحيح.
فمعاوية إذاً، لم يكن يكسب الشرعية في زمن الإمام علي×، ثمّ لم يكسب الشرعية في أوّل خلافة الإمام الحسن×، ثمّ وقع الصلح ضمن شروطٍ نكثها معاوية فيما بعد، فعادت الأُمور إلى سابق عهدها؛ فهو قَبْل الهدنة باغٍ شاقٌّ لعصا المسلمين، ثمّ نكث الشروط وأفصح عن حقيقة مطالبه، وهي الحكم والسلطان، فهو خارج عن الشرعية مجدّداً، ويحقّ للإمام الحسين× قتاله.
فاتّضح إذاً، إنّ معاوية بمخالفته الهدنة، بل وإعلانه أنّ هدفه هو الملك والسلطان، والاستيلاء على رقاب الناس، لم يبقَ له الحقّ الشـرعي ولا القانوني في البقاء على سدّة الحكم.
وإذا كان معاوية خارجاً عن الشرعية، فمن باب أولى أنْ تكون خلافة يزيد غير شرعية أيضاً، فكان لا بدّ من عودة الخلافة إلى الإمام الحسين× وفق ما ذكرناه في شروط الهدنة، وحينئذٍ يحقّ للإمام الحسين× الخروج على يزيد من الوجهتين الشرعية والقانونية؛ إذ لا مبرّر لخلافة معاوية، ولا لخلافة يزيد، بعد نكث معاوية لشروط الهدنة مع الإمام الحسن×، أي أنّ نفس الشـرعية التي أقرّ بها الجميع في قتال الإمام علي× لمعاوية باعتباره باغياً وخارجاً عن الخلافة، هي نفسها تسوّغ للإمام الحسين× الخروج على معاوية، وكذلك على يزيد.
ولربّ قائلٍ أنْ يقول: إنّه إذا كان للإمام الحسين× حقّ قتال معاوية، فلماذا لم يخرج، وانتظر موت معاوية، ثمّ خرج في عهد يزيد، خصوصاً أنّ شيعة العراق تحرّكت نحو الإمام الحسين×، وكتبوا إليه في خلع معاوية والبيعة له، «فامتنع عليهم، وذكر أنّ بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له نقضه، حتّى تمضـي المدّة، فإن مات معاوية نظر في ذلك[185]؟
والجواب عن ذلك هو أنْ نقول: إنّ الظروف التي أجبرت الإمام الحسن× على الصلح وترك القتال هي هي الظروف التي منعت الإمام الحسين من قتال معاوية؛ فمعاوية بعد الصلح أصبح هو الخليفة على كافّة المسلمين، وله سطوة أكبر، وقادر على بث الإشاعات والإيحاء للناس بخلاف الحقائق، ونكثه للصلح لم يكن كافٍ لوحده للانقضاض على حكمه، فذلك يحتاج إلى إعلام وافر، يوصل صوت الحقيقة إلى جميع المسلمين، والحال إنّ الإعلام بيد السلطة، وقيادة الجيش بيدها، فالتحرّك في عهد معاوية لا يؤدّي إلى نصـرٍ آني، ولا مستقبلي، فمعاوية بدهائه، وبقوّة سلطانه، وكونه من الصحابة، سيُطيح بأيّ ثورة تخرج ضدّه، بل قد يصوّر للناس أنّ الثائر هو الشاقّ لعصا المسلمين، والمفرِّق لكلمتهم، وبذلك تفقد الثورة أيّ قيمةٍ لها، خصوصاً أنّه يلوّح بورقة الصلح التي يمتلكها، فنكثه للصلح لا يمكن أنْ يصل إلى جميع أصقاع المجتمع الإسلامي، مع أنّ الجانب الإعلامي ـ وهو الأهمّ في هكذا أُمور ـ كان بيد السلطة، فمن الممكن أنْ يشيع معاوية أنّ الإمام الحسين× نكث العهد، وخالف الشروط، وخرج للقتال، فلا يبقى لثورته أيّ قيمة يمكن أنْ تؤثر بالمجتمع وتهزّ ضميره. فالحسين× يبحث عن ثورة صافية، لا يمكن أنْ تُلصق بها أيّ شائبة؛ ولذا حين وصلت لمعاوية بعض الوشايات حول استعداد الإمام الحسين× للتحرّك، كتب إليه معاوية كتاباً لوّح فيه باستخدام ورقة الصلح، جاء فيه: «أمّا بعد، فقد انتهت إليّ أُمور عنك لست بها حرياً؛ لأنّ من أعطى صفقة يمينه جديرٌ بالوفاء، فاعلم رحمك الله إنّي متى أُنكرك تستنكرني، ومتى تكدني أكِدك، فلا يستفزنّك السفهاء الذين يحبّون الفتنة. والسلام[186].
فظروف المجتمع الإسلامي التي ما زالت على حالها، ولم يطرأ عليها ذلك التغيّر الكبير، الذي يهيّء للثورة. وسلطة معاوية وسيطرته على كافّة مناطق المجتمع الإسلامي، كانت تؤهّله في بث الأخبار التي يريدها، ويمكّنه من خلالها تشويه أيّ ثورة تخرج ضدّه، خصوصاً مع إمكان تلويحه بالصلح، هذه الأُمور تعدّ في مقدّمة الأسباب التي منعت الحسين× من الثورة على معاوية.
أضِف إلى ذلك أنّ أحد أهمّ الشروط في الصلح كان لم يُنقض بعد، وهو أنّ الخلافة تعود إلى طريقها الطبيعي بعد موت معاوية، فتكون للحسن×، ثمّ للحسين×، فلم يكن معاوية في وقتها قد بايع لولده يزيد بولاية العهد.
وبعد البيعة لولده بولاية العهد بدأت علامات الرفض من المجتمع الإسلامي لسياسة معاوية، وكان الحسين× أوّل المعارضين، وعارض معه عبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وسيأتي بيان ذلك لاحقاً إن شاء الله.
وبقيت المعارضة خلال هذه الفترة على أُوجها، إلى أنْ تُوفّي معاوية، فكانت الظروف مهيّئة لمعارضة يزيد والوقوف بوجهه، وهو ما حصل على أرض الواقع.
اتّضح ممّا قدمناه أنّ النبيّ’ لم يترك أمر هذه الأُمّة سدى، بل عيّن الخلفاء من بعده، وهم اثناعشر خليفة، أوّلهم عليّ×، وآخرهم المهديّ#، لكنّ الأُمّة وبعد وفاة الرسول’، تنصّلت من عهده، فكان أوّل انحراف في مسارها هو اجتماع السقيفة، والذي بانت فيه الصـراعات القبلية والحزبية، وانتهى إلى تنصيب أبي بكر خليفة على المسلمين، من دون إجماعٍ للأُمّة، بل ومن دون استشارة أهل الحلّ والعقد، ثمّ إنّ الخليفة أبا بكر نصّ على عمر من دون مشورة المسلمين، بل مع رفضهم لذلك؛ الأمر الذي يكشف عن عدم مسيرهم على نظرية واضحة في مسألة الخلافة، فتارة ببيعة ناقصة، وأُخرى بتنصيب مخالف لإرادة المسلمين.
لم يسِر عمر بالمسلمين على جادّة الصواب، وله مخالفات كثيرة للسُّنة النبوية، وختمها بنظرية جديدة في الخلافة، إذ جعلها بين ستّة، مع ترجيح كفّة عبد الرحمن بن عوف عند تساوي الطرفين.
انتهت هذه المهزلة الجديدة بتنصيب عثمان خليفة على المسلمين، والذي ابتعد كثيراً عن جادّة الصواب؛ ممّا أدّى بالأُمّة الإسلامية أنْ تثور عليه ثورة عارمة أودت بقتله.
توجّهت الجماهير صوب عليّ× تطالبه بتولّي الخلافة، وإقامة العدل الذي ضُيّع من قبل مَن سبقوه. تسلّم عليّ× الخلافة، وبدأ بإجراءاته العادلة، فأقصـى ولاة عثمان، وفرّق المال بالتساوي بين المسلمين، وأرجع الإقطاعات والهدايا التي بذلها عثمان من بيت مال المسلمين.
واجه عليّ في سياسته اعتراضات الطبقة المُترفة والمنتفعة من حكم عثمان؛ ممّا أدّى إلى نشوب حرب أولى بينه وبين مناوئي عدالته، والذين تستّروا بلباس المطالبة بدم عثمان، فكانت الجمل، وكانت آلاف القتلى من المسلمين.
كما أنّ معاوية لم يخضع لحكم عليّ× بنفس الستار المتقدّم، وهو المطالبة بدم عثمان، فأراد عليّ إعادته إلى الطاعة، فكانت حرب صفين، التي كادت تقضـي على يد الفتنة والتفرقة لو لا مكائد معاوية وابن العاص في رفعهم المصاحف، وما تلاها من غشّ وتلاعب في قضية التحكيم، التي ساهمت في تفتيت جيش الإمام×، وأدّت إلى حرب ثالثة مع الخوارج، الذين انشقّوا عن جيش الإمام×.
لم تُسفر حرب صفين عن إرجاع معاوية عن غيّه، بل إنّ مهزلة التحكيم والتلاعب الذي جرى بها لم يُسفر عن نتيجة مرضية، ولم يتوحّد المسلمون على خليفة يجمعهم، فبقي عليّ وأتباعه في جانب، والشام بحكم معاوية في جانبٍ آخر.
استشهد عليّ في مسجد الكوفة بغدر خارجي، واتجهت الناس صوب الإمام الحسن× وبايعته على الخلافة، وأخذ× يُعِدّ العدّة لإرجاع معاوية عن غيّه، وإجباره على الدخول في الطاعة، لكنّ مكر معاوية وتخاذل جيش الإمام× أدّى بالإمام أن يقبل بالصلح مع معاوية، وفق شروط عديدة، أهمّها عودة الخلافة إليه، ومن ثمّ إلى أخيه الحسين× من بعده.
لم يفِ معاوية بشـروط الهدنة، ممّا يعني استمراره في غيّه، وشقّه لعصا المسلمين، خصوصاً بتوليته ولده يزيد خليفة على المسلمين، وهذا الأمر أعطى الحقّ الشرعي والقانوي للإمام الحسين× في الخروج، سواء كان على معاوية أو يزيد.
وبعد أنْ كان الحق للإمام الحسين× في الخروج، فهو لم يرَ أنّ الظروف كانت مواتية للثورة مادام معاوية حيّا، مع امتلاكه شرعية وقانونية الخروج؛ إذ لا شرعيّة تُذكر لمعاوية خصوصاً بعد نكثه لشروط الصلح والهدنة، ورأى أنّ الظروف مواتية للثورة في عهد يزيد.
والنتيجة أنّ صلح الإمام الحسن× شرعن إعادة الخلافة لأصحابها، وشرعن الخروج على مغتصبي الخلافة.
الفصل الثالث: مشروعية الثورة في ضوء عدم مشروعية الحاكم
مشروعية الثورة في ضوء عدم مشروعية الحاكم
اتّضح من خلال ما تقدّم أنّ معاوية كان باغياً خارجاً على إمام زمانه، ولم يخضع للطاعة، وبقي الأمر كذلك، حتّى وقع الصلح بينه وبين الإمام الحسن× ضمن شروط معيّنة، لكنّه خالف الشـروط ولم يلتزم بها، وأعلن هدفه الحقيقي الذي يسعى وراءه، وهو التسلّط على رقاب المسلمين، وعليه فإنّه بقي خارجاً عن الشرعية، ويترتّب على ذلك عدم شرعية أفعاله التي منها: توليته ولده يزيد على رقاب المسلمين.
وفي هذا الفصل نريد التدرّج في البحث، ونغضّ الطرف عن النقطة السابقة، ونرى هل أنّ يزيد تتوفّر فيه صفات الحاكم الإسلامي، وهل تمتلك خلافته أُسساً شرعية يستند عليها؛ لذا سيكون هذا الفصل ناظراً إلى مشـروعية الثورة من هذه الزاوية دون غيرها.
صفات الحاكم وشروطه في الإسلام (نظرة مختصرة)
بعد أنْ عرفنا سابقاً أنّ وجود الحاكم يعدّ ضرورة لكلّ مجتمع من المجتمعات، نريد أنْ نتعرّف في هذا المبحث على المواصفات والشـرائط التي يتحلّى بها الحاكم في الإسلام، لذا سنذكر بعض الكلمات في ذلك:
1ـ قال الماوردي: «وأمّا أهل الإمامة، فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:
أحدها: العدالة على شروطها الجامعة.
والثاني: العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح معها مباشرة ما يدرك بها.
والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض.
والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.
والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
والسابع: النسب، وهو أنْ يكون من قريش؛ لورود النصّ فيه، وانعقاد الإجماع عليه[187].
2ـ قال ابن خلدون: «وأمّا شروط هذا المنصب، فهي أربعة: العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء، ممَّا يؤثّر في الرأي والعمل، واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي.
فأمّا اشتراط العلم فظاهر؛ لأنّه إنّما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى إذا كان عالماً بها، وما لم يعلمها لا يصحّ تقديمه لها، ولا يكفي من العلم إلّا أن يكون مجتهداً؛ لأنّ التقليد نقص، والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال.
وأمّا العدالة، فلأنّه منصب ديني، ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها، فكان أولى باشتراطها فيه، ولا خلاف في انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها. وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف. وأمّا الكفاية، فهو أن يكون جريئاً على إقامة الحدود، واقتحام الحروب، بصيراً بها، كفيلاً يحمل الناس عليها، عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء، قويّاً على معاناة السياسة...[188].
3ـ قال العلامة الحلّي: «الأوّل: أنْ يكون مكلّفاً...
الثاني : أنْ يكون مسلماً؛ ليراعي مصلحة المسلمين والإسلام، وليحصل الوثوق بقوله، ويصح الركون إليه، فإن غير المسلم ظالم، وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) [189].
الثالث: أنْ يكون عدلاً؛ لما تقدّم، فإنّ الفاسق ظالم، ولا يجوز الركون إليه والمصير إلى قوله؛ للنهي عنه في قوله تعالى: (وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)؛ ولأنّ الفاسق ظالم، فلا ينال مرتبة الإمامة، لقوله تعالى: (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [190].
الرابع : أن يكون حرّاً...
الخامس: أن يكون ذَكَراً...
السادس: أن يكون عالماً؛ ليعرف الأحكام ويعلّم الناس، فلا يفوت الأمر عليه بالاستفتاء والمراجعة.
السابع: أن يكون شجاعاً؛ ليغزو بنفسه، ويعالج الجيوش، ويقوى على فتح البلاد، ويحمي بيضة الإسلام.
الثامن: أن يكون ذا رأي وكفاية؛ لافتقار قيام نظام النوع إليه.
التاسع: أن يكون صحيح السمع والبصر والنطق؛ ليتمكّن من فصل الأُمور.
وهذه الشرائط غير مُختلف فيها.
العاشر: أن يكون صحيح الأعضاء، كاليد والرجل والأُذن.
وبالجملة اشتراط سلامة الأعضاء من نقصٍ يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، وهو أوّل قوليّ الشافعية.
الحادي عشر: أن يكون من قريش؛ لقوله×: الأئمّة من قريش. وهو أظهر قولي الشافعية، وخالف فيه الجويني...
الثاني عشر: يجب أن يكون الإمام معصوماً عند الشيعة؛ لأنّ المقتضـي لوجوب الإمامة ونصب الإمام جواز الخطأ على الأُمّة، المستلزم لاختلال النظام، فإنّ الضـرورة قاضية بأنّ الاجتماع مظنّة التنازع والتغالب...
الثالث عشر: أنْ يكون منصوصاً عليه من الله تعالى، أو من النبيّ’، أو ممَّن ثبتت إمامته بالنصّ فيهما...
الرابع عشر: أن يكون أفضل أهل زمانه؛ ليتحقّق التميّز عن غيره، ولا يجوز عندنا تقديم المفضول على الفاضل، خلافاً لكثير من العامّة؛ للعقل والنقل...
الخامس عشر: أن يكون منزّهاً عن القبائح؛ لدلالة العصمة عليه، ولأنّه يكون مستحقّاً للإهانة والإنكار عليه، فيسقط محلّه من قلوب العامّة، فتبطل فائدة نصبه، وأن يكون منزّهاً عن الدناءات والرذائل، كاللعب، والأكل في الأسواق، وكشف الرأس بين الناس، وغير ذلك ممَّا يسقط محلّه ويوهن مرتبته، وأن يكون منزّها عن دناءة الآباء وعهر الأُمّهات، وقد خالفت العامّة في ذلك كلّه[191].
4ـ قال سعد الدين التفتازاني: «ويشترط أنْ يكون مكلّفاً مسلماً عدلاً حرّاً ذكراً مجتهداً شجاعاً، ذا رأي وكفاية سميعاً بصيراً ناطقاً قريشياً[192].
فهذه جملة من الشرائط التي ذكروها فيمَن يجب أنْ يتولّى الخلافة، سواء كانت عند السنّة أو عند الشيعة، ولسنا هنا بصدد تحقيق هذه الشرائط خارجاً، بل غرضنا البحث عن مدى تحقّق هذه الشـرائط من عدمها عند يزيد بن معاوية.
لكن رأينا من الضروري أنْ نلقي قليلاً من الضوء على شرطين مهمّين في الخلافة، وهما العلم بمعنى الاجتهاد، وكذا العدالة.
أمّا شرط العلم بمعنى الاجتهاد، فمضافاً لما ذكرناه، فقد قال الشاطبي: «إنّ العلماء نقلوا الاتّفاق على أنّ الإمامة الكبرى لا تنعقد إلّا لمَن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع[193].
وقال الجويني: «فالشرط أنْ يكون الإمام مجتهداً بالغاً مبلغ المجتهدين مستجمعاً صفات المفتين، ولم يُؤثَر في اشتراط ذلك خلاف[194]. وقال: «من شرائط الإمام أنْ يكون من أهل الاجتهاد، بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث، وهذا متّفق عليه[195].
وقال القلقشندي، وهو يذكر شروط الإمامة: «الثاني عشر: العلم المؤدّى إلى الإجتهاد في النوازل والأحكام، فلا تنعقد إمامة غير العالم بذلك؛ لأنّه محتاج لأنْ يصـرف الأمور على النهج القويم ويجريها على الصـراط المستقيم، ولأن يعلم الحدود، ويستوفى الحقوق، ويفصل الخصومات بين الناس، وإذا لم يكن عالماً مجتهداً لم يقدر على ذلك[196].
وأمّا العدالة، فقد نصّ عليها غير واحد من أهل العلم، قال القاضي عياض: «ولا تنعقد لفاسقٍ ابتداءً[197].
وقال القرطبي: «ولا خلاف بين الأُمّة في أنّه لا يجوز أنْ تُعقد الإمامة لفاسق[198].
وقال الماوردي: «فأمّا الجرح في عدالته، وهو الفسق، فهو على ضربين:
أحدهما: ما تابع فيه الشهوة.
والثاني: ما تعلّق فيه بشبهة.
فأمّا الأوّل منهما فمتعلّق بأفعال الجوارح، وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً وانقياداً للهوى، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها[199].
وقال القلقشندي: «العاشر: العدالة فلا تنعقد إمامة الفاسق وهو المُتابع لشهوته، المُؤثر لهواه من ارتكاب المحظورات، والإقدام على المنكرات؛ لأنّ المراد من الإمام مراعاة النظر للمسلمين والفاسق لم ينظر في أمر دينه، فكيف ينظر في مصلحة غيره[200].
وقد استدلّ جمهور الفقهاء والمتكلّمين على اشتراط العدالة في الإمام، بقوله تعالى: (فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) [201].
قال الشوكاني: «وقد استدلّ بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أنّ الإمام لا بدّ أنْ يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كما ورد؛ لأنّه إذا زاغ عن ذلك كان ظالماً[202].
وقال الفخر الرازي: «قال الجمهور من الفقهاء والمتكلّمين: الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد الإمامة له، واختلفوا في أنّ الفسق الطارئ هل يبطل الإمامة أو لا؟ واحتجّ الجمهور على أنّ الفاسق لا يصلح أنْ تُعقد له الإمامة بهذه الآية، ووجه الاستدلال بها من وجهين:
الأول: ما بيّنا أنّ قوله: (قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) جوابٌ لقوله: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي)، وقوله: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِي) طلب للإمامة التي ذكرها الله تعالى، فوجب أنْ يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة، ليكون الجواب مطابقاً للسؤال، فتصير الآية كأنّه تعالى قال: لا ينال الإمامة الظالمين، وكلّ عاصٍ فإنّه ظالم لنفسه، فكانت الآية دالّة على ما قلناه.
الثاني: أنّ العهد قد يُستعمل في كتاب الله بمعنى الأمر، قال الله تعالى: ( ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)، يعني ألم آمركم بهذا، وقال الله تعالى: (ﭴﭵﭶﭷﭸ)، يعني أمرنا، ومنه عهود الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم.
إذا ثبت أن عهد الله هو أمره؛ فنقول: لا يخلو قوله: ( ﯘﯙﯚﯛ) من أنْ يريد أن الظالمين غير مأمورين، وأن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحلّ مَن يقبل منهم أوامر الله تعالى، ولمّا بطل الوجه الأول؛ لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم، ثبت الوجه الآخر، وهو أنّهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم فيها، فلا يكونون أئمّة في الدين، فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق. قال×: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ودلّ أيضاً على أنّ الفاسق لا يكون حاكماً، وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلك لا تقبل شهادته، ولا خبره عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، ولا فتياه إذا أفتى، ولا يقدم للصلاة وإن كان هو بحيث لو اقتدي به فإنّه لا تفسد صلاته، قال أبو بكر الرازي: ومن الناس مَن يظنّ أنّ مذهب أبي حنيفة أنّه يجوّز كون الفاسق إماماً وخليفة، ولا يجوز كون الفاسق قاضياً، قال: وهذا خطأ، ولم يفرّق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم في أن شرط كلّ واحد منهما العدالة، وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة، وأحكامه غير نافذة، وكيف يجوز أن يُدّعى ذلك على أبي حنيفة، وقد أكرهه ابن هبيرة في أيام بني أُميّة على القضاء، وضربه فامتنع من ذلك فحُبس، فلحّ ابن هبيرة وجعل يضربه كلّ يوم أسواطاً[203].
وقد صرّح الجصّاص بأنّ الآية تثبت بطلان إمامة الفاسق، وأنّه لا يكون خليفة، وأنّ مَن نصّب نفسه في هذا المنصب وهو فاسق، لم يلزم الناس اتّباعه ولا طاعته، مستشهداً بعد ذلك بقول النبيّ’: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق[204].
وهناك أقوال عديدة جدّاً تنصّ على اشتراط العلم والعدالة في الخليفة، وأنّ الخلافة لا تنعقد بدونهما، بل إنّ هذا الرأي هو الذي عليه الجمهور كما عرفنا.
وأمّا انطباق هذين الشرطين على يزيد أو عدمه، فهو ما سنعرفه في المبحث اللاحق.
اتّضح أنّ الإمامة لا تنعقد لمَن اختلّت فيه الشـرائط، خصوصاً العلم والعدالة، بل ذهب بعضهم إلى أنّ الفسق كما يمنع من انعقاد الإمامة، فإنّ طروّه يمنع من استدامتها أيضاً، لذا سنركّز في هذا المبحث على صفات يزيد وخصاله، لنرى مدى انطباق الشروط عليه من عدمه.
ومن خلال جولة في كتب التاريخ والتراجم سيتّضح أنّ الرجل لا يتمتّع بمقومات الخلافة، فإنّ أهمّ شرطين يتوفّر عليهما الخليفة غير متحقّقين عند يزيد بن معاوية، فلا هو بالعالم المجتهد في أحكام الشـريعة، ولا هو بالعدل المستقيم طبق المحجّة البيضاء، بل لم يكن له حضور واضح في الساحة الإسلامية مع وجود ثلّة من الصحابة، ومن أهل الحلّ والعقد، وعلى رأسهم الحسين بن علي×.
ولكي تتّضح الصورة جيّداً حول يزيد، نرى من الضرورة أنْ نسلّط قليلاً من الضوء على بيئة يزيد ونسبه من حيث الأب والأُم؛ لما للبيئة وعامل الوارثة من تأثير على حياة الشخص، ثمّ نستقرئ بعض كلمات المؤرّخين وأهل السير حول شخصية يزيد، ونختم بالإشارة لما قام به يزيد أيّام خلافته؛ لأنّ أفعال الشخص وتصرّفاته تكشف مقداراً كبيراً عن حالته السابقة أيضاً، إذ لا يمكن أنْ نتصور شخصاً متّسماً بالعدالة والاستقامة، ثمّ يتحوّل مباشرة إلى شخص منحرف، موغل بدماء المسلمين، هاتكاً لأعراضهم!
أمّا من جهة الأُمّ فهو ابن ميسون بنت بجدل الكلبية، وكانت قبل زواجها من معاوية متزوّجة من ابن عمّها زامل بن عبد الأعلى، الذي قُتل على يد أخيه[205].
وميسون هذه من عائلة نصرانية معروفة، فهي من نصارى كلب[206]، وكانت تعيش في البادية، فلمّا تزوّجت معاوية لم يرُق لها حال القصور والترف الذي يعيشه معاوية، وحنّت إلى البادية، فأنشدت قائلة:
|
للبس عباءةٍ وتقرّ عيني |
أحبُّ إِليَّ من لبسِ الشفوفِ |
|
وبيت تخفق الأرياح فيه |
أحبّ إليَّ من قصـرٍ منيف |
|
وبكر تتبع الأظعان صعب |
أحبّ إِلي من بغلٍ زفوفِ |
|
وكلب ينبح الأضياف دوني |
أحبّ إِليّ من هرٍّ ألوفِ |
|
وخرقٌ من بني عمِّي فقير |
أحبّ إلي من علج عنيفِ |
فلمّا سمعها معاوية طلقها، وألحقها بأهلها، وقال عند ذلك: ما رضيت ابنة بجدل حتى جعلتني علجاً عنيفاً، الحقي بأهلك[207].
فمضت إلى بادية بني كلب ويزيد معها[208]، وقال المدائني: إنّها كانت حاملاً به[209].
فكانت نشأة يزيد وتربيته بين أخواله النصارى، فكان طبيعياً أنْ يشبّ على شرب الخمور وارتكاب أنواع الموبقات والمحرّمات، يقول الشيخ عبد الله العلايلي، أحد علماء الأزهر: «إذا كان يقيناً أو يشبه اليقين أنّ تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة، أو بعبارةٍ أُخرى: كانت مسيحية خالصة، فلم يبقَ ما يُستغرَب معه أن يكون متجاوزاً مستهتراً مستخفّاً بما عليه الجماعة الإسلامية، لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها، أي: حساب ولا يقيم لها وزناً [210].
وأمّا من جهة الأب فهو ابن معاوية بن أبي سفيان، المتمرّد على خليفة زمانه، والمتمسّك بكرسي السلطة من دون إذن شرعي في ذلك، فلا هو مشمول بنظرية النصّ، ولا هو ممَّن بويع من قِبل أهل الحلّ والعقد، بل بغى على إمام زمانه عليّ بن أبي طالب× ولم يرضخ لطاعته، ثمّ بغى على إمام زمانه الحسن بن علي× ولم يرضخ لطاعته أيضاً، لكنّ الظروف أوصلت الأُمور إلى الصلح الذي مكّن معاوية من الاستيلاء على مقدّرات المسلمين، وفق شروطٍ معيّنة لم يفِ بها معاوية، ممّا يعني أنّ معاوية لم يكسب الشرعية حتّى من جهة الصلح.
إذاً؛ فمعاوية من جهة الخلافة هو باغٍ غاصب للخلافة، متسلّط على المسلمين بقوّة السيف.
وأمّا من جهة فضائله، فقد نصّ العلماء على عدم ثبوت أيّ فضيلة في حقّه، قال الشوكاني: «وقال الحاكم: سمعت أبا العبّاس محمّد بن يعقوب بن يوسف يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: لا يصحّ في فضل معاوية حديث[211].
ونقل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، عن ابن الجوزي، عن إسحاق بن راهويه، أنّه قال: «لم يصحّ في فضائل معاوية شيء، ثمّ قال: «وأخرج ابن الجوزي أيضاً من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، سألت أبي: ما تقول في علي ومعاوية؟ فأطرق ثمّ قال: اعلم أنّ علياً كان كثير الأعداء، ففتّش أعداؤه له عيباً فلم يجدوا، فعمدوا إلى رجلٍ قد حاربه فأطروه كياداً منهم لعلي.
قال ابن حجر: «فأشار بهذا إلى ما اختلقوه لمعاوية من الفضائل، ممّا لا أصل له، وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة، لكن ليس فيها ما يصحّ من طريق الإسناد، وبذلك جزم إسحاق ابن راهويه، والنسائي، وغيرهما، والله أعلم[212].
وقال الفتني: «وباب فضائل معاوية ليس فيه حديثٌ صحيح[213].
بل وردت روايات في ذمّه وتنقيصه، بل وبعضها في تكفيره، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عبّاس، أنّ النبيّ’ قال في حقّ معاوية: «لا أشبع الله بطنه[214]. وهذه ظاهرة ظهوراً بيّناً، بل صريحة في ذمّه، ومحاولات تأويلها عن طريق وضع بعض الأحاديث عن النبيّ’ بأنّه بشر وإذا ما سبّ أو شتم أو جلد أو دعا على شخصٍ، فإنّما هو كفارة له، وقربة يتقرّب بها إلى الله يوم القيامة، فهي تأويلات فاسدة، لم يُكتب لها أي نصيب من النجاح، فهي ليست إلاّ محاولة لخلط الأوراق وتضييع للحقائق، فإذا كان ذمّ النبيّ’ لشخص هو فضيلة، ومدحه أيضاً فضيلة، فكيف نستكشف الإنسان السيء من وجهة نظر النبيّ’، وأي طريقةٍ يَتّبع’ ليوضّح لنا زيف البعض ونفاقهم؟ فعلى هذا المبنى، كلّما ذم النبيّ’ شخصاً سوف تكون فضيلة له، وإذا مدح شخصاً فهي أيضاً فضيلة له[215]، كما أنّ هذه الأحاديث تُسيء إلى النبيّ’ من أجل تبرئة بعض الصحابة، وتصوّره سبّاباً وشتّاماً بدون وجه حقٍّ؛ معلّلين ذلك بأنّه بشر يُخطئ ويصيب، ناسين أو متناسين بأنّ السب والشتم يتنافى مع أبسط وأدنى قيم الأخلاق التي يتحلّى بها الفرد العادي، فضلاً عن نبيّنا محمّد الذي بُعث ليُتمم مكارم الأخلاق!!!
على أنّ هناك روايات ذامّة لمعاوية غير قابلة للتأويل، منها على سبيل المثال، ما أخرجه البلاذري في الأنساب، قال: «وحدّثني إسحاق وبكر بن الهيثم قالا: حدّثنا عبد الرزاق بن همام، أنبأنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: كنت عند النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي، قال: وكنت تركت أبي قد وضع له وضوء، فكنت كحابس البول مخافة أن يجيء، قال: فطلع معاوية، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم): هو هذا [216].
قال العلامة السيّد حسن السقاف في تحقيقه على كتاب العتب الجميل: «قال الحافظ السيّد أحمد بن الصدّيق الغماري في (جؤنة العطار: 2/154): وهذا حديث صحيح على شرط مسلم، وهو يرفع كلّ غمة عن المؤمن المتحيّر في شأن هذا الطاغية، قبّحه الله، ويقضي على كلّ ما يموّه به المموّهون في حقه...[217].
وكذلك فقد ثبت أنّ معاوية كان يرتكب المحرمات وعلى رأسها شرب الخمر:
فقد أخرج أحمد بسنده إلى عبد الله بن بريدة، قال: «دخلت أنا وأبي على معاوية فأجلسنا على الفرش، ثم أتينا بالطعام، فأكلنا، ثمّ أتينا بالشراب فشرب معاوية، ثمّ ناول أبي، ثمّ قال: ما شربته منذ حرّمه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، ثمّ قال معاوية: كنت أجمل شباب قريش وأجودهم ثغراً، وما شيء كنت أجد له لذّة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن، أو إنسان حسن الحديث يُحدثني.
قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه على مسند أحمد: «إسناده قوي[218].
وقال الهيثمي: «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وقد اعترف على استحياء بأنّ في الخبر دلالة على شرب معاوية للخمر؛ لأنّ الهيثمي قطع عبارة معاوية التي قالها بعد أنْ شرب الخمر، وهي: «ما شربته منذ حرّمه رسول الله. وقال بعد تصحيح الحديث: «وفى كلام معاوية شيء تركته [219].
وهذا تدليسٌ صريح على القارئ، وإخفاء للحقائق، فإنّه من دون هذه العبارة لا يثبت أنّ ما شربه كان خمراً، بل يستفيد القارئ من جملة الرواية أنّه شرب لبناً، فهل يوجد مبرّر شرعي لقطع النص وإراءته على غير ما هو؟ وهل يكفي اعتراف الهيثمي بأنّه ترك شيئاً من كلام معاوية من دون أن يعرف القارئ ماهية وحقيقة هذا الشيء؟!
وهناك محاولات وتكلّفات لأثبات أنّ معاوية قد شرب لبناً لا خمراً لا ترقى للمستوى العلمي، وفيها التفاف على النصّ ومؤدّاه، خصوصاً أنّ نفس ترك الهيثمي لعبارة معاوية، وتصريحه بأنّه ترك من كلام معاوية شيئاً؛ يدلّ على أنّ فهمه من العبارة كان مثل ما فهمناه.
كما ثبت أنّ هناك أموراً كثيرة محرّمة كان يفعلها معاوية، مع إقراره بأنّ رسول الله’ نهى عنها، كلبس الذهب والحرير وغيرها، فقد جاء في الخبر الصحيح الذي أخرجه أبو داود في سننه، قال: «حدّثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، حدثنا بقية عن بحير عن خالد، قال: وفد المقدام بن معديكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام: أعلِمتَ أنّ الحسن بن علي توفّي؟ فرجّعَ المقدام ـ أي قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ـ، فقال له رجل: أتراها مصيبة؟ قال له: ولمَ لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) في حجره، فقال: (هذا منّي وحسين من علي)؟! فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله (عزّ وجلّ)، قال: فقال المقدام: أمّا أنا فلا أبرح اليوم حتّى أُغيظك وأُسمعك ما تكره. ثمّ قال: يا معاوية، إنْ أنا صدقت فصدّقني، وإن أنا كذبت فكذّبني. قال: أفعل. قال: فأنشدك بالله، هل سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) نهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأُنشدك بالله، هل تعلم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك بالله، هل تعلم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. قال: فوالله، لقد رأيت هذا كلّه في بيتك يا معاوية، فقال معاوية: قد علمت أنّي لن أنجو منك يا مقدام...[220].
وقد صحّح الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة[221]، لكنّه اقتصر على نقل النسائي الذي اختصر الحديث، حيث أورد الحديث بالسند أعلاه عن بحير عن خالد، قال: «وفد المقدام بن معدى كرب على معاوية، فقال له: أنشدك بالله هل تعلم أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) نهى عن لبوس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم [222].
وقد نوّه الألباني إلى أنّ الحديث أطول من ذلك بقوله: «وهو عند أبي داود قطعة من حديثٍ طويل [223].
كما أنّ معاوية أوغل في دماء المسلمين، وقتل الآلاف المؤلّفة من المسلمين، سواء في حرب صفّين أو في بعثه ابن أبي إرطأة إلى اليمن، وما ارتكبه فيها من فجائع، أو في قتله الخلّص من المؤمنين أمثال عمرو بن الحمق الخزاعي، وحجر بن عدي وأصحابه، وغيرهم الكثير الكثير.
وغرضنا ممّا تقدّم، هو إشارة موجزة إلى أنّ معاوية بن أبي سفيان لم يكن على النهج القويم، وإنّ حياته امتلأت بالمخالفات للسنّة المحمّدية، ونختم هنا بما ما ورد عن الحسن البصري، حيث قال: «أربع خصالٍ كنَّ في معاوية، لو لم يكن فيه إلّا واحدة لكانت موبقة، وهي أخذه الخلافة بالسيف من غير مشاورة، وفي الناس بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، واستخلافه ابنه يزيد، وكان سكّيراً خمّيراً، يلبس الحرير ويضـرب بالطنابير، وادّعاؤه زياداً، وقد قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقتله حجر بن عدي وأصحابه، فيا ويلاً له من حِجرٍ وأصحاب حِجر [224].
ومن خلال ذلك يتّضح أنّ البيئة التي عاش فيها يزيد هي بيئة غير صالحة، وبعيدة كلّ البعد عن مبادئ وقيم السماء، وموغلة في الانحراف وحبّ التسلّط والملك، ولو على حساب جماجم الصحابة والصالحين، فكان من الطبيعي أنْ تنغرس تلك الصفات الرديئة في نفس يزيد، خصوصاً وهو يعيش ما بين أخواله النصارى، أو مدلّلاً في قصر الخلافة تحت رعاية والده؛ فكان لذلك إفرازات صبّت على المسلمين وابلاً من المصائب، فلم يرَ المسلمين في خلافة يزيد سوى القتل والدم، والانحراف الصريح عن جادّة الشرع.
يزيد في كلمات الصحابة والتابعين والعلماء والمؤرِّخين
أشرنا إلى أنّ يزيد لم يكن له حضور واضح في الساحة الإسلامية، خصوصاً مع وجود ثلّة من أهل البيت^ والصحابة، أمثال الحسين بن علي× وعبد الله بن عبّاس، وابن الزبير، وغيرهم الكثير الكثير، سواء كانوا من البيت العلوي، أو الصحابة، أو التابيعن ممّن هم أفضل من يزيد بعشرات بل مئات المرات؛ وهذا هو السبب الحقيقي الذي جعل التاريخ يُغفل حياة يزيد قبل تولّيه للخلافة، فلا تجد في التاريخ ما يوضّح سيرة يزيد وحياته بصورة واضحة، سوى إشارات من هنا وهناك؛ لأنّ الساحة تعجّ بالكثيرين من غيره من أصحاب السير الواضحة، فكان وجوده وجوداً خاملاً لم يعبأ به أحد، خصوصاً أنّ أُمّه طُلّقت من أبيه معاوية كما تقدّم، وعادت إلى أهلها في البادية.
فالسبب الحقيقي في إغفال التاريخ ليزيد هو خموله، وعدم وجود مايذكره المؤرِّخون من مناقب ومآثر وفضائل له، لا كما يحاول المدافعون عنه تصويره بأنّ ذلك يدخل ضمن حملة التعتيم على أخباره، والتشهير بسيرته، فالمؤرِّخون رغم ميولهم إلى تلك الكفّة، لكنّهم لم يذكروا عن يزيد شيئاً يدلّ على فضله، أو مبادئه ومناقبه، بل إنّهم ذكروا يزيد في مفاسده التي قام بها بعد تولّيه الخلافة، وأشاروا إشارات قليلة تدلّ على فسق الرجل وانحرافه قبل الخلافة؛ لذا سنحاول أنْ نتتبّع روايات التاريخ، وأقوال الصحابة والتابعين، والعلماء والمؤرّخين، حول يزيد بن معاوية:
أ ـ يزيد على لسان الصحابة والتابعين
1ـ لعلّ أوّل ما يستوقفنا في هذا الصدد هو موقف الحسين بن عليّ×، الذي لا يختلف أحد في فضله وجلالة أمره، وأنّه من أهل البيت^ الذين نزلت فيهم آية التطهير، فالحسين× ذكر بعض العلل التي جعلته يرفض بيعة يزيد، والتي منها فسق الرجل وشربه للخمور، فقال للوليد بن عتبة: «ويزيد رجلٌ فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلنٌ بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله[225].
وقال لابن الزبير: «اُنظر أبا بكر، إنّى أبايع ليزيد! ويزيد رجل فاسق معلن الفسق، يشرب الخمر، ويلعب بالكلاب والفهود، ويبغض بقية آل الرسول! لا والله، لا يكون ذلك أبداً [226].
2ـ إنّ نفس الرجال المطيعين لمعاوية، بل معاوية نفسه كان على علم ودراية ومعرفة بأنّ يزيد لا يمتلك ما يؤهّله للخلافة؛ لذا حينما اقترح عليه المغيرة تولية يزيد طمعاً في بقائه على ولاية الكوفة، أجابه معاوية قائلاً: «ومَن لي بهذا.
فمعاوية يفصح بجوابه هذا إلى أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تدبير، وإلى أناس تقوم به، فقال المغيرة: «أكفيك أهل الكوفة، ويكفيك زياد أهل البصـرة، وليس بعد هذين المِصرين أحدٌ يخالفك.
ولمّا رجع المغيرة إلى أصحابه قال: «لقد وضعت رجل معاوية في غرزٍ بعيد الغاية على أُمّة محمد، وفتقت عليهم فتقاً لا يُرتق أبداً[227].
وحين وصل كتاب معاوية إلى زياد وهو في البصرة يعلمه فيه بفكرة المغيرة، أجابه زياد بحقيقة ما يعرفه عن يزيد قائلاً: «فما يقول الناس، إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد، وهو يلعب بالكلاب والقرود! ويلبس المصبّغ! ويدمن الشـراب! ويمشـي على الدفوف، وبحضرتهم الحسين ابن علي، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر! ولكن تأمره أن يتخلّق بأخلاق هؤلاء حولاً وحولين، فعسينا أن نموّه على الناس [228].
وفي المصادر الأُخرى أنّ زياداً أحضر عبيد بن كعب النميري، وأخبره: أنّ يزيد صاحب رسلة وتهاون، مع ما قد أُوله به من الصيد، وطلب منه أنْ يذهب إلى معاوية ويخبره بفعلات يزيد، ويطلب منه التأنّي في الأمر[229].
3ـ وفي تاريخ اليعقوبي، أنّ عبد الله بن عمر حين رفض بيعة يزيد، قال: «نبايع من يلعب بالقرود والكلاب، ويشـرب الخمر، ويظهر الفسوق! ما حجّتنا عند الله؟![230].
4ـ وإنّ عبد الله بن الزبير قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية خالق، وقد أفسد علينا ديننا [231].
وجاء في تاريخ خليفة بن خياط: «حدّثنا أبو الحسن عن بقية بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: لمّا بلغ يزيد بن معاوية أن أهل مكة أرادوا ابن الزبير على البيعة فأبى، أرسل النعمان بن بشير الأنصاري وهمام بن قبيصة النميري إلى ابن الزبير يدعوانه إلى البيعة ليزيد، على أن يجعل له ولاية الحجاز، وما شاء وما أحبّ لأهل بيته من الولاية، فقدما على ابن الزبير، فعرضا عليه ما أمرهما به يزيد، فقال ابن الزبير: أتأمراني ببيعة رجل يشـرب الخمر ويدع الصلاة ويتبع الصيد...؟! [232].
وفي أنساب الأشراف للبلاذري، قال: «قال الواقدي وغيره في روايتهم: لّما قتل عبد الله بن الزبير أخاه عمرو بن الزبير، خطب الناس فذكر يزيد بن معاوية، فقال: يزيد الخمور، ويزيد الفجور، ويزيد الفهود، ويزيد القرود، ويزيد الكلاب، ويزيد النشوات، ويزيد الفلوات. ثمّ دعا الناس إلى إظهار خلعه وجهاده... [233].
5ـ وقال الصحابي عبد الله بن حنظلة: «يا قوم، اتّقوا الله وحده لا شريك له، فوالله ما خرجنا على يزيد حتّى خفنا أنْ نُرمى بالحجارة من السماء، أنّ رجلاً ينكح الأمّهات والبنات والأخوات، ويشرب الخمر، ويدع الصلاة، والله لو لم يكن معي أحدٌ من الناس لأبليت لله فيه بلاءً حسناً [234].
ولمّا قدم المدينة عائداً من عند يزيد، أتاه الناس فقالوا: ما وراءك؟ قال: «أتيتكم من عند رجلٍ والله، لو لم أجد إلّا بنيّ هؤلاء لجاهدته [235].
6ـ وقال المنذر بن الزبير، وكان أحد الوفد الذين التقوا يزيد: «والله، لقد أجازني بمائة ألف درهم، وإنّه لا يمنعني ما صنع إلى أن أخبركم خبره وأصدقكم عنه، والله إنّه ليشرب الخمر، وإنّه ليسكر حتى يدَع الصلاة [236].
7ـ وذكر البلاذري والطبري ـ واللفظ للثاني ـ أنّ وفد وجهاء المدينة العائد من لقاء يزيد، أظهروا شتمه، وقالوا: «إنّا قدمنا من عند رجل ليس له دين، يشـرب الخمر، ويعزف بالطنابير، ويضـرب عنده القيان، ويلعب بالكلاب، ويسامر الخراب والفتيان، وإنّا نشهدكم أنّا قد خلعناه [237].
وقال ابن كثير: «وكان سبب وقعة الحرة أنّ وفداً من أهل المدينة، قدموا على يزيد بن معاوية بدمشق، فأكرمهم وأحسن جائزتهم، وأطلق لأميرهم، وهو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر، قريباً من مائة ألف، فلمّا رجعوا ذكروا لأهليهم عن يزيد ما كان يقع منه من القبائح في شربه الخمر، وما يتبع ذلك من الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتها، بسبب السكر، فاجتمعوا على خلعه، فخلعوه عند المنبر النبوي [238].
8ـ وقال الصحابي معقل بن سنان الأشجعي (استُشهد يوم الحرة) لمسلم بن عقبة، عند لقائه به في طبرية ليلة خروجه من يزيد: «...فنرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق بن الفاسق، ونبايع لرجل من المهاجرين أو الأنصار، وقد أسرّ مسلم هذه الكلمة في قلبه، وذكّره بها يوم الحرة، وأمر بقتله فقُتل[239].
9ـ وقال عوانة: «كان مسور بن مخرمة [وهو صحابي] وفد إلى يزيد قبل ولاية عثمان بن محمد، فلمّا قدم، شهد عليه بالفسق وشرب الخمر، فكتب إلى يزيد بذلك، فكتب إلى عامله يأمره أن يضرب مسوراً الحدّ، فقال أبو حرّة:
أيشـربها صهباء كالمسك ريحها أبو خالد ويضرب الحدّ مسور[240].
10ـ قال محمد بن أبي السري: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي نية، عن نوفل بن أبي الفرات، قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، فذكر رجلٌ يزيد، فقال: قال أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، فقال: «تقول أمير المؤمنين! وأمر به فضُرِب عشرين سوطاً[241].
إلى غير ذلك من الشهادات العديدة من الصحابة والتابعين الذين عاصروا يزيد، وعرفوا فسقه وانحلاله واستهتاره بالقيم والمبادئ.
ب ـ يزيد على لسان العلماء والمؤرِّخين
1ـ قال البلاذري: «حدّثني العمري، عن الهيثم بن عدي، عن ابن عياش وعوانة، وعن هشام بن الكلبي، عن أبيه وأبي مخنف وغيرهما، قالوا: كان يزيد بن معاوية أوّل مَن أظهر شرب الشـراب، والاستهتار بالغناء والصيد، واتّخاذ القيان والغلمان، والتفكّه بما يضحك منه المُترفون من القرود، والمعاقرة بالكلاب والديكة، ثمّ جرى على يده قتل الحسين، وقتل أهل الحرة، ورمي البيت وإحراقه[242].
2ـ وقال البلاذري أيضاً: «وحدّثني محمّد بن يزيد الرفاعي، حدّثني عمّي، عن ابن عيّاش، قال: خرج يزيد يتصيّد بحوارين وهو سكران، فركب وبين يديه أتان وحشيّة، قد حمل عليها قرداً، وجعل يركض الأتان ويقول:
أبا خلف احتل لنفسك حيلة فليس عليها إن هلكت ضمان
فسقط فاندقّت عنقه[243].
3ـ وقال المدائني: «كان يزيد ينادم على الشراب سرجون مولى معاوية[244].
4ـ وأخرج ابن عساكر بسنده عن ابن شبة النميري ـ وهو من المؤرّخين الموثوق بهم ـ ما حاصله: «أنّه لمّا حجّ الناس في خلافة معاوية جلس يزيد بالمدينة على شراب، فاستأذن عليه ابن عبّاس والحسين بن علي، فأمر بشـرابه فرُفع، وقيل له: إنّ ابن عباس إنْ وجد ريح شرابك عرفه. فحجبه، وأذن للحسين بن علي... ثمّ دعا بقدحٍ فشربه، ودعا بآخر، فقال: اسقِ أبا عبد الله يا غلام. فقال الحسين: عليك شرابك أيّها المرء، لا عين عليك منّي، فشـرب يزيد وقال:
|
ألا يا صاح
للعجب |
دعوتك ثمّ لم
تجب |
|
إلى القينات
والشهوات |
والصهباء والطرب |
|
وباطية مكلّلة |
عليها سادة
العرب |
|
وفيهنّ التي
تبلّت |
فؤادك ثمّ لم
تثبِ |
فنهض الحسين وقال: بل فؤادك يا بن معاوية تبلّت[245].
وقد أشكل ابن عساكر على سند الرواية بالانقطاع، حيث إنّ ابن شيبة لم يعاصر يزيد، بل بينهما فاصل زماني كبير.
لكنّ هذا غير مضرّ في القضايا التاريخية؛ فإنّ ابن شيبة من ثقات المؤرّخين، المعتمدين أوّلاً، ولأنّ المنهج التاريخي لا يعتمد على صحّة الإسانيد فقط، بل قد يعتمد على تحشيد وتجميع القرائن؛ إذ لو اعتمدنا على صحّة الأسانيد فقط لضاع من التاريخ الكثير الكثير، ولما أمكن لأحدٍ ـ سواء من السلفية أو غيرهم ـ أنْ يثبت ويتمسّك بالكثير من القضايا التاريخية، ولبقيت هناك فجوات لا يمكن سدّها ولا معالجتها.
5ـ وقال المسعودي: «وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود وفهود ومنادمة على الشراب، وجلس ذات يوم على شرابه، وعن يمينه ابن زياد، وذلك بعد قتل الحسين، فأقبل على ساقيه فقال:
|
اسْقِني شَرْبَةً ترَوِّي مُشاشي |
ثم مِلْ فاسق مثلها ابن زياد |
|
صاحب السـرّ والأمانة عِندي |
ولتسديد مغنمي وجهادي |
ثمّ أمر المغنّين فغنّوا به.
وغلب على أصحاب يزيد وعمّاله ما كان يفعله من الفسوق، وفي أيامه ظهر الغناء بمكّة والمدينة، واستُعملت الملاهي، وأظهر الناس شرب الشراب، وكان له قرد يُكنّى بأبي قيس، يحضره مجلس منادمته، ويطرح له متكّأ، وكان قرداً خبيثاً، وكان يحمله على أتانٍ وحشية قد ريضت وذلّلَتْ لذلك بسـرجٍ ولجام، ويسابق بها الخيل يوم الحلبة، فجاء في بعض الأيام سابقاً، فتناول القصبة ودخل الحجرة قبل الخيل، وعلى أبي قيسٍ قَباء من الحرير الأحمر والأصفر مشمّر، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق، وعلى الأتان سرج من الحرير الأحمر، منقوش ملمّع بأنواع من الألوان، فقال في ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم:
|
تمسّك أبا قيس بِفَضْلِ عِنانها |
فليس عليها إن سقطت ضمان |
|
ألا من رأى القرد الذي سبقت به |
جياد أمير المؤمنين أتان[246]. |
6ـ وقال ابن الطقطقي: «وكان يزيد بن معاوية أشدّ الناس كلفاً بالصيد، لا يزال لاهياً به، وكان يُلبس كلاب الصيد الأساور من الذهب، والجلال المنسوجة منه، ويهب لكلّ كلب عبداً يخدمه[247].
7ـ وقال ابن كثير: «وقد رُوي أنّ يزيد كان قد اشتهر بالمعازف، وشرب الخمر، والغناء، والصيد، واتّخاذ الغلمان والقيان والكلاب، والنطاح بين الكباش والدباب والقرود، وما من يومٍ إلّا يُصبح فيه مخموراً، وكان يشدّ القرد على فرسٍ مسرّجة بحبالٍ ويسوق به، ويُلبس القرد قلانس الذهب، وكذلك الغلمان، وكان يسابق بين الخيل، وكان إذا مات القرد حزن عليه. وقِيل: إنّ سبب موته أنّه حمل قردة وجعل ينقزها فعضّته[248].
وقال أيضاً: «وكان فيه أيضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات، وإماتتها في غالب الأوقات[249].
8ـ وقال الذهبي في ترجمة يزيد: «كان قوياً شجاعاً، ذا رأيٍّ وحزم وفطنة وفصاحة، وله شعر جيّد، وكان ناصبياً، فظّاً، غليظاً، جلفاً، يتناول المسكر، ويفعل المنكر، افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين، واختتمها بواقعة الحرة، فمقته الناس، ولم يُبارَك في عمره، وخرج عليه غير واحد بعد الحسين، كأهل المدينة قاموا لله، وكمرداس بن أدية الحنظلي البصـري، ونافع بن الأزرق، وطواف بن معلى السدوسي، وابن الزبير بمكة[250].
فالذهبي يصفه بأنّه ناصبي، والناصبي هو المبغض لعليّ بن أبي طالب×، والمبغض لعليّ منافق بنصّ قول النبيّ’ الوارد في صحيح مسلم، بأنّه لا يحبّ عليّ إلّا مؤمن، ولا يُبغضه إلّا منافق[251].
وقال في كتابه تاريخ الإسلام: «ولمّا فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل، وقتل الحسين وإخوته وآله، وشرب يزيد الخمر، وارتكب أشياء منكرة، بغضه الناس، وخرج عليه غير واحد، ولم يُبارك الله في عمره[252].
وقال في ميزان الاعتدال: «مقدوح في عدالته، ليس بأهل أنْ يروى عنه[253].
9ـ وقال ابن حجر: «وكان منهمكاً في لذّاته، ومقته أهل الفضل؛ بسبب قتله الحسين، ثمّ بسبب وقعة الحرة، والله المستعان[254].
10ـ وقال ابن تغري: «وكان فاسقاً قليل الدين، مدمن الخمر، وهو القائل:
|
أقول لصحبٍ ضمّت الكأس شملهم |
وداعي صبابات الهوى يترنّم |
|
خذوا بنصيبٍ من نعيمٍ ولذّةٍ |
فكلٌّ وإنْ طال المدى يتصـرّم |
وله أشياء كثيرة غير ذلك، غير أنّني أضربت عنها؛ لشهرة فسقه ومعرفة الناس بأحواله[255].
11ـ وفي السيرة الحلبية: «وسبب بناء عبد الله بن الزبير للكعبة، أنّ يزيد بن معاوية لمّا وجّه الجيش عشرين ألف فارس وسبعة آلاف راجل ـ وأميرهم مسلم بن قتيبة ـ لقتال أهل المدينة؛ لمّا علم أنّهم خرجوا عن طاعته، أي وأظهروا شتمه، وأعلنوا بأنّه ليس له دين؛ لأنّه اشتهر عنه نكاح المحارم، وإدمان شرب الخمر، وترك الصلاة، وأنّه يلعب بالكلاب، فقد ذكر بعض ثقات المؤرِّخين أنّه كان له قرد يُحضره مجلس شرابه، ويطرح له وسادة، ويسقيه فضلة كأسه، واتّخذ له أتاناً وحشية، قد ربضت له وصُنع لها سرجاً من ذهب، يركب عليها ويسابق بها الخيل في بعض الأيام، وكان يلبس عليه قباء وقلنسوة من الحرير الأحمر.
وقد استفتى الكيا الهراسي ـ من أكابر أئمّتنا معاشر الشافعية كان من رؤوس تلامذة إمام الحرمين نظير الغزالي ـ عن يزيد هذا، هل هو من الصحابة؟ وهل يجوز لعنه؟
فأجاب: بأنّه ليس من الصحابة؛ لأنّه ولد في أيّام عمر بن الخطاب، وللإمام أحمد قولان ـ أي في لعنه ـ تلويح وتصـريح، وكذلك الإمام مالك، وكذا لأبي حنيفة، ولنا قولٌ واحد، التصريح دون التلويح، وكيف لا يكون كذلك، وهو اللاعب بالنرد، والمصيد بالفهود، ومدمن الخمر وشعره في الخمر معلوم! وكان على ما أفتى به الكيا الهراسى من جواز التصريح بلعنه أستاذنا الأعظم الشيخ محمد البكري، تبعاً لوالده الأستاذ الشيخ أبي الحسن، وقد رأيت في كلام بعض أتباع أُستاذنا المذكور في حقّ يزيد ما لفظه: زاده الله خزياً وَضِعَةً، وفي أسفل سجّين وَضَعَهُ.
وفي كلام ابن الجوزي أجاز العلماء الورعون لعنه، وصنّف في إباحة لعنه مصنّفاً.
وقال السعد التفتازاني: إنّي لأشكّ في إسلامه، بل في إيمانه، فلعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه[256].
12ـ وقال الآلوسي: «وعندي أنّ بغضه (رضي الله تعالى عنه) [يعني عليَّ بن أبي طالب] من أقوى علامات النفاق، فإن آمنت بذلك فيا ليت شعري ماذا تقولون في يزيد الطريد، أكان يحب علياً أم كان يبغضه، ولا أظنّك في مرية في أنّه (عليه اللعنة) كان يبغضه أشدّ البغض، وكان يبغض ولديه الحسن والحسين (على جدّهما وأبويهما وعليهما الصلاة والسلام)، كما تدلّ على ذلك الآثار المتواترة معناً، وحينئذٍ لا مجال لك من القول بأنّ اللعين كان منافقاً[257].
13ـ ونقل الذهبي عن محمد بن أحمد بن مسمع، قال: «سكر يزيد، فقام يرقص، فسقط على رأسه فانشق وبدا دماغه[258].
إلى غير ذلك من الأقوال الدالّة بكلّ وضوح على فسقه وانحرافه عن الشريعة المقدّسة.
ج ـ أفعال يزيد بعد توّليه الخلافة
لكي تتّضح صورة يزيد بصورةٍ أجلى وأوضح؛ كان لا بدّ من الوقوف ـ ولو مجملاً ـ على ما قام به يزيد وجيشه عند تولّيه الخلافة، وقد نصّ المؤرّخون وأهل السير على أنّ يزيد ابن معاوية حكم ثلاث سنوات وعدّة أشهر، ارتكب فيها أنواع الموبقات والأعمال القبيحة، التي يهتزّ لها عرش الرحمن، ففي سنة (61هـ) ارتكب جريمته الكبرى، المتمثّلة بقتل الحسين بن علي× في كربلاء، وفي سنة (63هـ) أباح مدينة رسول الله ثلاث أيام في وقعة الحرّة، وارتكب فيها أفحش الأعمال، فقتل الصحابة والصالحين، وانتهك أعراضهم.. ثمّ زحف على مكّة فضُربت بالمنجنيق.
يقول ابن حجر العسقلاني: «وامتنع من بيعته الحسين بن علي (رضي الله عنهما) وسار إلى الكوفة باستدعائهم له إليها، فجهّز له عبيد الله بن زياد ـ أمير الكوفة ليزيد بن معاوية ـ الجيوش فقُتل في يوم عاشوراء سنة إحدى وستين.
وامتنع من بيعة يزيد أيضاً عبد الله بن الزبير، وأقام بمكة، فراسله يزيد مراراً، ثمّ إنّ أهل المدينة خلعوا يزيد، فجهّز إليهم الجيوش، فكانت وقعة الحرة بالمدينة، فقُتل فيها عدد كثير من الصحابة والتابعين، واستبيحت المدينة لجهلة أهل الشام.
ثمّ سارت الجيوش إلى مكّة لقتال ابن الزبير، فحاصروه بمكة، وأُحرقت الكعبة بعد أن رُميت بالمنجنيق[259].
ونحاول هنا أنْ نركّز البحث نوعاً على ما جرى في المدينة المنورة من أفعالٍ منكرة قام بها جيش يزيد، بحيث لم يستطِع ابن تيمية، ولا ابن كثير، ولا غيرهم من كبار علماء السلفية أنْ يتفصّوا من هذه الجرائم، فها هو ابن كثير يقرّ بالخطأ الفاحش الذي قام به يزيد في أهل المدينة، فيقول: «وقد أخطأ يزيد خطأً فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة: أنّ يبيح المدينة ثلاثة أيام، وهذا خطأٌ كبير فاحش، مع ما انضمّ إلى ذلك من قتل خلقٍ من الصحابة وأبنائهم، وقد تقدّم أنّه قتل الحسين وأصحابه على يدي عبيد الله بن زياد، وقد وقع في هذه الثلاثة أيام من المفاسد العظيمة في المدينة النبوية ما لا يُحدّ ولا يُوصف، ممّا لا يعلمه إلاّ الله عزَّ وجلَّ[260].
كما أنّ ابن تيمية لم يستطِع الهروب ممّا حصل في وقعة الحرّة، فقال في ذلك: «فإنَّ أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته [يقصد يزيد بن معاوية]، وأخرجوا نوّابه وأهله، فبعث إليهم جيشاً، وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف، ويبيحها ثلاثاً، فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثاً يقتلون، وينهبون، ويفتضّون الفروج المحرَّمة، ثمّ أرسل جيشاً إلى مكَّة، وتُوفِّي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فُعل بأمره[261].
وسبقهم في ذكر تلك التفاصيل الشنيعة ابن حزم الأندلسي، حيث ذكر تلك الواقعة بنوعٍ من التفصيل، ارتأينا أنْ ننقل بعض كلامه؛ لأهمّيته في الباب، قال: «... أغزى يزيد الجيوش إلى المدينة حرم رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وإلى مكّة حرم الله تعالى، فقتل بقايا المهاجرين والأنصار يوم الحرّة، وهي أيضاً أكبر مصائب الإسلام وخرومه؛ لأنّ أفاضل المسلمين وبقيّة الصحابة، وخيار المسلمين من جلّة التابعين، قُتلوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً، وجالت الخيل في مسجد رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر، ولم تُصلَّ جماعة في مسجد النبي (صلّى الله عليه وسلّم)، ولا كان فيه أحد، حاشا سعيد بن المسيب، فإنّه لم يفارق المسجد، ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان، ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة المري بأنّه مجنون لقتله، وأكره الناس على أنْ يبايعوا يزيد بن معاوية على أنّهم عبيدٌ له، إن شاء باع، وإن شاء أعتق، وذكر له بعضهم البيعة على حكم القرآن وسنّة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فأمر بقتله، فضرب عنقه صبراً، وهتك مسرف أو مجرم الإسلام هتكاً، وأنهب المدينة ثلاثاً، واستخفّ بأصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، ومُدّت الأيدي إليهم وانتهبت دورهم، وانتقل هؤلاء إلى مكة (شرّفها الله تعالى)، فحُوصرت، ورُمي البيت بحجارة المنجنيق، تولّى ذلك الحصين بن نمير السكوني في جيوش أهل الشام؛ وذلك لأنّ مجرم بن عقبة المري مات بعد وقعة الحرة بثلاث ليال، ووُلّيَ مكانه الحصين بن نمير، وأخذ الله تعالى يزيد أخذ عزيزٍ مقتدر، فمات بعد الحرة بأقلّ من ثلاثة أشهر وأزيد من شهرين، وانصرفت الجيوش عن مكة[262].
كما ورد عن مالك بن أنس أنّ عدد الذين قُتلوا يوم الحرة من حملة القرآن سبعمائة[263].
وفي تاريخ الإسلام للذهبي: «وقال جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، قال: نهب مسرف ابن عقبة المدينة ثلاثاً، وافتضّ فيها ألف عذراء[264].
فهذه هي أعمال يزيد ووُلاته، قتلٌ، وتدمير، واستخفاف بالمبادئ والقيم، واستحلال للأعراض، وما إلى ذلك ممَّا يندى له جبين البشـرية، ولا يمكن أنْ نتخيّل أنّ شخصاً كان يتّسم بالعدالة والتقوى ثمّ يقدم على هذه الأُمور، فإنّ ما ارتكبه يزيد من قبائح الأُمور تنمّ وتكشف عن انحرافه السابق، وفسقه، وعدم مبالاته، كما شهد عليه الصحابة والتابعون، وجزم به المؤرّخون وأصحاب السير على ما تقدّم.
وممّا تقدّم تبيّن أنّ الرجل فاسق لا يصلح للخلافة، كما اتّضح أنّ الرجل ليس من أهل العلم والاجتهاد، فهو منشغل عن العلم بشرب الخمر، ومنادمة وملاعبة القرود والكلاب، فلا شغل له بالسنّة النبوية، فضلاً عن أنْ يكون مجتهداً في أحكام الشريعة، وقد عرفنا أنّ العلم بمعنى الاجتهاد هو أحد شروط الخلافة أيضاً.
ودعوى أنّه لم يثبت فسق يزيد، فهي مجازفة وبعيدة عن الرؤية العلمية الصحيحة، فالأخبار التي نقلناها، وأقوال أهل السير التي ذكرناها، غير مختصّة بمؤرخٍ معيّن، ولا مقتصرة على خبر آحاد، بل هي أخبار متظافرة دلّت على فسق الرجل، وبها جزم عدّة من أهل العلم والحديث والتاريخ، بما فيهم ممَّن يُصنّف من رؤوس المدرسة السلفية، كالذهبي الذي جزم بفسق الرجل، وقد دعمنا ذلك بموبقات يزيد وأفعاله القبيحة، التي ارتكبها بعد خلافته، والدالّة على فسقه السابق، وعدم مبالاته بالدين. وأفعاله القبيحة هذه اعترف بها ابن تيمية، وابن كثير، وابن حزم، وغيرهم من أعمدة علماء القوم.
ثمّ يمكن أنْ ندلّل على فسق الرجل، وعدم عدالته بنفس فعل الحسين وابن الزبير؛ باعتبارهما صحابيين وفق مبنى أهل السنّة، فبضميمة الحديث الشـريف المتّفق في معناه بين الفريقين وهو: مَن مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتةً جاهليّة.
فسوف يكون الحسين وابن الزبير ماتا ميتةً جاهلية؛ لأنّهما لم يبايعا يزيد بن معاوية إلى أنْ قُتلا، وهما من الصحابة العدول ومن أهل الجنّة! وميتة الجاهلية تعني أمّا الموت على ضلالة، أو الموت على كفر، فكيف يمكن أنْ نجمع بين ذلك؟!
فإمّا أنْ نقول: إنّ يزيد كان فاسقاً، وغير مؤهّل للخلافة، ولا تجب بيعته، بل لا تجوز، وهو المطلوب.
أو نقول: إنّ يزيد كان عادلاً، مستحقاً للخلافة، ولازمه أنّ الحسين وابن الزبير ماتا ميتةً جاهلية، وهذا ما لا يقول به أحد، خصوصاً أنّ الحسين× أحد سيدي شباب أهل الجنّة، وفق الحديث المتواتر الذي سنُشير إليه لاحقاً: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة.
من الأُمور الخطيرة التي كانت لها تداعيات إلى يومنا هذا، هي مسألة عدم تدوين الحديث في عهد النبي’؛ بدعاوى مختلفة لا تمّت إلى الحقيقة بصلة، الأمر الذي أدّى إلى فتح باب الوضع على مصراعيه، خصوصاً أنّ التدوين حصل في فترة بني أُميّة، فاختلطت الأُمور بعضها ببعض، وكثرت الروايات الموضوعة، وضاعت الروايات الصحيحة بين تلك الآلاف المؤلّفة من الروايات، التي نُقلت وكُتبت في القرنين الثاني والثالث، فكان من الضرورة بمكان أنْ تُوضع تلك الروايات ـ خصوصاً ما يتعلّق منها بحكّام بني أُميّة ـ على طاولة البحث والتنقيب؛ ليتسنّى لنا معرفة الواقع من عدمه.
وحيث إنّ يزيد معروف بفسقه ومجونه، حاولوا أنْ يضعوا فيه رواية تناسب حاله، فكان أنْ وضعوا رواية القسطنطينة، بعنوان أنّ أوّل جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وبضميمة أنْ يزيد كان قائد الجيش كما يزعمون؛ فيكون يزيد مغفوراً له، وبذلك تُطوى صحيفته السوداء، وتُتناسى أيّام لهوه وفجوره، بل لتذهب قتلى واقعة الحرة إلى الجحيم، ولتُنتهك أعراض الصحابة والتابعين، فيزيد مغفورٌ له، مهما قتل وانتهك وعمل!
ورواية القسطنطينية أخرجها البخاري عن أمّ حرام، أنّها سمعت النبيّ’ يقول: «أول جيش من أُمّتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم، ثمّ قال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم): أول جيش من أُمّتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: لا[265]. وقيصـر هو ملك الروم، ومدينته هي القسطنطينية.
وقد تمسّك ابن تيمية بهذا الحديث في دفاعه عن يزيد، وأنّه مغفور له في أكثر من مناسبة[266].
وقال المُهلّب: «في هذا الحديث منقبة لمعاوية؛ لأنّه أوّل من غزا البحر، ومنقبة لولده يزيد؛ لأنّه أوّل من غزا مدينة قيصر[267].
غير أنّ هذه الرواية محلّ نقاش سواء في المتن أو السند، فرجال سندها كلّهم من أهل الشام، وأهل الشام معروفون بنصبهم وعدائهم لعلّي وأهل البيت^، فهم منافقون بنصّ قول النبيّ’ لعليّ: إنّه لا يحبّك إلّا مؤمن، ولا يُبغضك إلّا منافق[268].
وبطبيعة الحال لا يمكن التمسّك برواية ينقلها المنافقون، خصوصاً وهي في مدح أعداء أهل البيت^.
ويكفي في عدم التعويل عليها أنّها تدور على ثور بن يزيد الحمصـي؛ فهو شامي من حمص، وأهل حمص كانوا شديدي النصب والعداء لعليّ×، قال ياقوت الحموي: «ومن عجيب ما تأمّلته من أمر حمص، فساد هوائها وتربتها، اللذين يُفسدان العقل، حتى يُضرب بحماقتهم المثل، إنّ أشد الناس على عليّ (رضي الله عنه) بصفين مع معاوية كان أهل حمص، وأكثرهم تحريضاً عليه وجدّاً في حربه[269].
وكان جدّ ثور بن يزيد قد شهد صفين مع معاوية، وقُتل يومئذٍ، فكان ثور إذا ذكر عليّاً× قال: «لا أُحبُّ رجلاً قتل جدّي[270].
وقال ابن حجر: «كان يُرمى بالنصب[271].
أضف إلى ذلك أنّ الأوزاعي، وابن المبارك، وغيرهما، كانوا ينهون عن الكتابة عنه، وكان الثوري يقول: خُذوا عنه واتّقوا لا ينطحكم بقرنيه. ولمّا قدم المدينة نهى مالك عن مجالسته[272].
هذا من جهة السند، وأمّا من جهة المتن فقد ردّها نخبة من علماء أهل السنّة، فقد نقل الحافظ ابن حجر عن المحدّث محمّد بن عبد الواحد الصفاقسـي التونسي، المعروف بابن التين، شارح البخاري، وعن ابن المنير، أنّهما قالا بما حاصله: إنّ يزيد خارج من ذلك العموم بدليلٍ خاصّ «إذ لا يختلف أهل العلم أنّ قوله (صلّى الله عليه وسلّم) مغفورٌ لهم مشروط بأنْ يكونوا من أهل المغفرة، حتّى لو ارتدّ واحدٌ ممَّن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتّفاقاً؛ فدلّ على أنّ المراد: مغفورٌ لمَن وُجد شرط المغفرة فيه منهم[273].
وكذلك ردّ المناوي الدلالة المدّعاة للحديث، ونفى دخول يزيد فيه، ذاكراً نحو ما تقدّم، فقال: «لا يلزم منه كون يزيد بن معاوية مغفوراً له لكونه منهم؛ إذ الغفران مشروط بكون الإنسان من أهل المغفرة، ويزيد ليس كذلك، لخروجه بدليلٍ خاصّ، ويلزم من الجمود على العموم أنّ مَن ارتدّ ممَّن غزاها مغفورٌ له. وقد أطلق جمع محقّقون حلّ لعن يزيد به، حتّى قال التفتازاني: الحقّ أنّ رِضى يزيد بقتل الحسين، وإهانته أهل البيت، ممَّا تواتر معناه، وإن كان تفاصيله آحاداً، فنحن لا نتوقّف في شأنه، بل في إيمانه (لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه). قال الزين العراقي: وقوله: بل في إيمانه، أي: بل لا يتوقّف في عدم إيمانه، بقرينة ما قبله وما بعده[274].
وذكر في موضع آخر: «تقدّم كون يزيد بن معاوية غير مغفور له، وإنْ كان من ذلك الجيش؛ لأنّ الغفران مشروطٌ بكون الإنسان من أهل المغفرة، ولا كذلك يزيد[275].
أضف إلى ذلك فإنّ دلالة الحديث المدّعاة لا تنسجم مع روايات أُخرى وردت في يزيد، منها ما ورد عن جابر، قال: «سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جَنبَي[276].
وعن السائب بن خلاد، أنّ رسول الله’ قال: «مَن أخاف أهل المدينة أخافه الله (عزّوجلّ) وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً[277].
وهناك روايات أُخرى وردت عن عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمر، وسعد بن أبي وقّاص، بنفس المضمون السابق[278].
كما ورد في البخاري وغيره، أنّه’ قال: «لا يكيد أهل المدينة أحد إلّا انماع كما ينماع الملح في الماء[279].
ومن المعلوم أنّ ما حصل في المدينة من قتلٍ ورعب، وانتهاك للإعراض وإباحتها ثلاثة أيّام، كان بأمر يزيد، كما اعترف بذلك ابن تيمية، وابن كثير، على ما قدّمناه.
على أنّ ابن كثير ربط بين موت يزيد وبين هذه الروايات، فقال: «وقد أراد بإرسال مسلم ابن عقبة توطيد سلطانه وملكه، ودوام أيامه من غير منازع، فعاقبه الله بنقيض قصده، وحال بينه وبين ما يشتهيه، فقصمه الله قاصم الجبابرة، وأخذه أخذ عزيزٍ مقتدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إنّ أخذه أليم شديد.
قال البخاري في صحيحه: حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا الجعيد، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، عن أبيها، قال: سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء، وقد رواه مسلم من حديث أبي عبد الله القراظ المديني...[280]، ثمّ ذكر عدّة من الروايات المتعلّقة بمَن أخاف أهل المدينة، وبطرقٍ متعدّدة.
ومن الروايات التي تتنافى مع مغفرة يزيد أيضاً، ما أخرجه البخاري، عن أبي هريرة، قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): يُهلك الناس هذا الحيّ من قريش، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أنّ الناس اعتزلوهم.
وفي البخاري أيضاً، بعد الحديث المتقدّم، عن أبي هريرة، قال: «سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أُمّتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: غلمة؟! قال أبو هريرة: إن شئت أن أُسمّيهم، بنى فلان، وبنى فلان[281].
وفي هذه الروايات إشارة جليّة إلى حكّام بني أميّة، وخصوصاً يزيد بن معاوية، ولذا فإنّ أبا هريرة كان يدعو ويقول: «اللهمّ إنّي أعوذ بك من رأس الستين، وإمارة الصبيان.
ومن المعلوم أنّ ولاية يزيد كانت في سنةّ (60هـ)، وبهذا أقرّ الحافظ ابن حجر، فقال معلّقاً على ذلك: «وفي هذا إشارة إلى أنّ أوّل الأغيلمة كان في سنة ستين، وهو كذلك، فإنّ يزيد ابن معاوية استُخلف فيها، وبقي إلى سنة أربع وستين فمات[282].
وذكر في موضع آخر أنّ أوّل هؤلاء الغلمة هو يزيد بن معاوية[283].
والنتيجة؛ إنّ الرواية التي يُراد التمسّك بها لإثبات مغفرة ذنوب يزيد لا يمكن الركون إليها، لا من جهة الإسناد، ولا من جهة المتن، فضلاً عن معارضتها بغيرها المتضمّنة للعن يزيد، وأنّ على يديه هلاك الأُمّة.
هذا كلّه على القول بأنّ يزيد قد شارك ذلك الجيش في غزوته، وأنّه كان قائدهم! إلّا أنّ بعض الأخبار تشكّك في ذلك، وتفيد أنّ يزيد امتنع عن اللحاق بالجيش، وتظاهر بالمرض، في حين أنّ الجيش أصابه الجوع، وتفشّت فيه الأمراض، وهو ينتظر قائده الملهم!
جاء في أنساب الأشراف: «أغزى معاوية الناس في سنة خمسين، وعليهم سفيان بن عوف، وأمّر يزيد بالغزو، فتثاقل واعتلّ، فأمسك عنه، وأصاب الناس في غزاتهم جوع وأمراض، فأنشأ يزيد يقول:
|
ما إن أبالي بما لاقت جموعهم |
بالفرقدونة من جوع ومن موم |
|
إذا اتّكأت على الأنماط في غرفٍ |
بدير مرّان عندي أمّ كلثوم. |
وأُمّ كلثوم هي زوجته بنت عبد الله بن عامر.
فيزيد لم يبالِ، ولم يهتم بما حلّ بالمسلمين، مادام عنده زوجته أُمّ كلثوم.
لكن الرواية حوّلت بعد ذلك هذا المتخاذل عن سوح الوغى إلى بطلٍ همام، فجاء فيها: «فبلغ معاوية شعره، فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان في أرض الروم؛ ليصيبه ما أصاب الناس ولو مات، فلحق به في فرس أنطاكية وبعلبكّ، وجماعة أنهضهم معه، فبلغ بالناس الخليج، وضرب بسيفه باب الذهب، وهزم الروم، وخرج وسفيان بالناس[284].
فيزيد إذاً لم يكن مع الجيش بادئ ذي بدئ، بل كان في قصره مع زوجته، ولم يبالِ بما حدث لهم من جوعٍ ومرض، والتحق بهم بعد ذلك؛ نتيجة قسم أبيه عليه! فتحوّل عند ذلك إلى بطلٍ ضرغام! فهل الاشتراك بالغزوة بهذا النحو تُوجب المغفرة ليزيد؟!
وقد اتّضح من جميع ما تقدّم أنّ الرجل لم تتحقّق فيه شروط الخلافة الإسلامية، فلا يمكن أنْ تنعقد له الخلافة، ولا يترتّب على تربّعه على عرش الخلافة أيّ أثر يُذكر.
تبيّن فيما سبق من البحث أنّ يزيد لم يكن مؤهّلاً للخلافة، فلا هو مشمول بنظرية النصّ التي يقول بها الشيعة الإمامية، ولا هو مشمول بشـرائط الإمام والخليفة التي بيّنها أهل السنّة، خصوصاً أنّه يفتقر لأهمّ شرطين في الخليفة الإسلامي، وهما العدالة والعلم بمعنى الاجتهاد.
ولكن لو تنزّلنا عمّا تقدّم، وسرنا خطوة إلى الأمام، وتفحّصنا الطريقة التي عُيّن فيها يزيد خليفة للمسلمين، لوجدنا أنّها لا تنطبق عليها الشـرائط أيضاً، فبيعة يزيد بدأت بتعيينه وليّاً للعهد في حياة أبيه، بحيلة من المغيرة بن شعبة، ورغبةً منه في البقاء والياً لمعاوية على الكوفة، بعد أنْ أراد معاوية عزله عنها، فاقترح عليه تنصيب يزيد وليّاً للعهد؛ تمهيداً لاستلامه الخلافة فيما بعد، مبيّناً استعداده لأخذ البيعة له من أهل الكوفة، على أنْ يكفيه زياد أهل البصرة[285].
ولمّا عاد المغيرة للكوفة تذاكر مع مَن يثق بهم، ومَن يعلم أنّهم أشياع لبني أُميّة، فأجابوا إلى بيعته، وبعث إلى معاوية منهم عشرة، ويُقال أكثر، وأعطاهم ثلاثين ألف درهم، وجعل عليهم ابنه موسى بن المغيرة، فلمّا قدموا على معاوية زيّنوا له بيعة يزيد، ودعوه إلى عقدها، فقال لهم معاوية: لا تعجّلوا بإظهار هذا، وكونوا على رأيكم.
ومعاوية لا تخفى عليه هذه الحيل والألاعيب، وهو رأسٌ في ذلك، فالتفت إلى موسى وقال له: «بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟. قال موسى بن المغيرة: «بثلاثين ألفاً. قال معاوية: «لقد هان عليهم دينهم.
وقيل: أرسل أربعين رجلاً وجعل عليهم ابنه عروة، فلمّا دخلوا على معاوية قاموا خطباء، وأوضحوا لمعاوية إنّما الذي جاء بهم هو النظر لأُمّة محمد’، وقالوا: يا أمير المؤمنين، كبرت سنّك، وخفنا انتشار الحبل، فانصب لنا علماً، وحدّ لنا حدّاً ننتهي إليه، فقال: أشيروا عليّ. فقالوا: نشير بيزيد بن أمير المؤمنين. فقال: أو قد رضيتموه؟ قالوا: نعم. قال: وذلك رأيكم؟ قالوا: نعم، ورأي مَن وراءنا.
فقال معاوية لعروة سرّاً عنهم: «بكم اشتري أبوك من هؤلاء دينهم.
قال: «بأربعمائة دينار. قال لقد وجد دينهم عندهم رخيصاً، وقال لهم: «ننظر ما قدّمتم له، ويقضي الله ما أراد، والأناة خير من العجلة فرجعوا[286].
فلمّا رأى معاوية ما صنع المغيرة قَوِي عزمه على البيعة ليزيد، وأرسل إلى زياد يستشيره في ذلك، لكن رأي زياد كان في التمهّل؛ لأنّه لا يرى صلاحية يزيد للخلافة، باعتباره صاحب رسلة وتهاون، مع ولهه بالصيد، وأراد إيصال رأيه هذا إلى معاوية، إلّا أنّ مستشاره كعب بن عبيد النمري ارتأى غير ذلك، وطلب منه الإذن في أنْ يلتقي بيزيد، ويبيّن له هناته التي ينقمها الناس عليه، وأنّ زياداً يتخوّف خلاف الناس عليه بسببها.
ولمّا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد، فأرسل إلى عبد الله بن عمر مائة ألف درهم فقبلها، فلمّا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر: هذا أراد! إنّ ديني عندي إذاً لرخيص، وامتنع. ثمّ بعث إلى مروان والي المدينة يستشيره في الأمر، ويخبره بأنّه أراد الخلافة ليزيد خوفاً من اختلاف الأُمّة من بعده، وطلب منه أنْ يعرض عليهم الأمر، ثمّ يخبره بذلك.
فعرض مروان الأمر عليهم، وأخبرهم برأي معاوية من توليته يزيد خوفاً على الأُمّة من الافتراق، لكنّ مروان فُوجئ بالمعارضة الشديدة من عبد الرحمن بن أبي بكر، حيث فضح مخطّطهم، ونطق بالحقيقة من دون خوف أو تردّد، فقال لمروان: «كذبت والله يا مروان، وكذب معاوية، ما الخير أردتما لأُمّة محمد، ولكنّكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلّما مات هرقل قام هرقل. فقال مروان: هذا الذي أنزل الله فيه: (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا) الآية. فسمعت عائشة مقالته، فقامت من وراء الحجاب، وقالت: يا مروان، يا مروان. فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه، فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن أنّه نزل فيه القرآن، كذبت والله، ما هو ولكنّه فلان بن فلان، ولكنّك أنت فضض من لعنة نبي الله[287].
وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك وفعل مثله ابن عمر وابن الزبير[288].
وأخرج الزبير عن عبد الله بن نافع قال: «خطب معاوية فدعا الناس إلى بيعة يزيد، فكلّمه الحسين بن علي، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، فقال له عبد الرحمن: أهرقلية؟! كلّما مات قيصر كان قيصر مكانه، لا نفعل والله أبداً.
وبسندٍ له إلى عبد العزيز الزهري، قال: «بعث معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر بعد ذلك بمائة ألف، فردّها وقال: لا أبيع ديني بدنياي[289].
وفي البدء والتاريخ للمقدسي: إنّ أهل المدينة امتنعوا عن بيعة يزيد: «فجاء معاوية حاجّاً في ألف فارس إلى المدينة، وتلقّاه الحسين وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير، فسلّموا عليه فلم يرد جواب سلامهم، وأغلظ بهم في القول وعنّف، وذلك حيلةً منه، فتوجّه القوم إلى مكة لما رأوا من جفائه، ودخل معاوية المدينة ولم يبقَ بها أحد لم يبايعه، وأخذ بيعة أهلها ليزيد، وفرّق فيهم أموالاً عظيمة.
ثمّ خرج إلى مكّة، فتلقاه الحسين بن علي، فلمّا وقع بصره عليه، قال: مرحباً بابن رسول الله، وسيد شباب أهل الجنّة. وأمر له بدابة، ثمّ طلع عليه عبد الله بن الزبير، فقال: مرحباً بابن حواري رسول الله وابن عمّته. وأمر له بدابّة، ثمّ كذلك كلمّا طلع عليه طالع، حيّاه وأمر له بدابة وصلة.
ثمّ دخل مكّة، وهداياه وجوائزه يروح عليهم ويغدو، حتى أنماهم الأموال، ثمّ أمر برواحله فعُلّقت بباب المسجد، وجمع الناس، وأمر بصاحب حرسه أن يقيم على رأس كلّ رجل من الأشراف رجلاً بالسيف، وقال: إن ذهب واحد منهم إلى أن يراجعني في كلامي فاضربوا عنقه. ثمّ صعد المنبر وخطب، فقال: إنّ هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، ولا يُبتزّ أمرٌ دونهم، ولا يُقضى أمرٌ عن غير مشورتهم، وقد بايعوا يزيد، فبايعوه بسم الله. فأمّا الأشراف فلم يمكنهم تكذيبه ومراجعته، وأمّا سائر الناس فلا جرأة لهم على الكلام، ولا علم لهم بشيء ممَّا يقول، فأخذ البيعة وركب رواحله وضرب إلى الشام[290].
وقد أخرج هذه القصّة خليفة ابن خيّاط بتفصيلٍ أكثر، وفيها أنّ معاوية حين دخل مكّة، وحاول أنْ يتظاهر باللين والحب للحسين وابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر، «فأقبل بعض القوم على بعضٍ فقالوا: أيّها القوم لا تُخدَعوا، إنّه والله، ما صنع بكم لحبّكم ولا كرامتكم، وما صنعه إلّا لما يريد فأعدّوا له جواباً. ثمّ اجتمع الرأي على أنّ الذي يتصدّى للكلام مع معاوية هو ابن الزبير بعد أنْ أخذ العهود والمواثيق على أنْ لا يخالفوه، فلمّا تكلّم معاوية وعرض عليهم بيعة يزيد، أجابه ابن الزبير بأنّهم يخيّرونه بين ثلاث خصال، إمّا أنْ يصنع مثل ما صنع الرسول’ أو مثل ما صنع أبو بكر أو مثل ما صنع عمر، ثمّ شرع ببيان هذه الخصال الثلاثة، غير أنّ الأمر لم يعجب معاوية، فرفض ذلك، وقال: «إمّا لا، فإنّي أحببت أنْ أتقدّم إليكم أنّه قد أُعذر من أنذر، وإنّه قدكان يقوم منكم القائم إليّ فيكذبني على رؤوس الناس، فأحتمل له ذلك وأصفح عنه، وإنّي قائم بمقالة إنْ صدقت فلي صدقي وإنْ كذبت فعليّ كذبي، وإنّي أُقسم لكم بالله لئن ردّ عليّ منكم إنسان كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إليّ رأسه، فلا يرعين رجل إلّا على نفسه. ثمّ دعا صاحب حرسه فقال: أقم على رأس كلّ رجل من هؤلاء رجلين من حرسك، فإنْ ذهب رجل يرد علي كلمة في مقامي هذا بصدق أو كذب فليضـرباه بسيفيهما، ثمّ خرج وخرجوا معه حتّى إذا رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: إنّ هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم، لا نستبدّ بأمر دونهم ولا نقضي أمراً إلّا عن مشورتهم، وإنّهم قد رضوا وبايعوا ليزيد بن أمير المؤمنين من بعده، فبايعوا بسم الله، فضربوا على يديه، ثمّ جلس على راحلته وانصرف، فلقيهم الناس فقالوا: زعمتم وزعمتم، فلمّا أرضيتم وحبيّتم فعلتم. قالوا: إنّا والله، ما فعلنا...[291].
وهذا الخبر سنده جيد، فقد رواه خليفة بن خياط وهو ثقة، عن وهب بن جرير وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم، عن جويرية بن أسماء وهو ثقة من رجال الشيخين أيضاً، عن أشياخ أهل المدينة، وذكر الخبر مفصّلاً، فالسند جمعي عن أشياخ أهل المدينة، وليس عن شخص أو شخصين، وهذا الجمع مع التعبير عنهم بأشياخ أهل المدينة يُدلّل على وثاقتهم، أو وثاقة بعضهم، أو لا أقل من تقوّي الطريق بمجموعهم.
وممّا ذكره المؤرّخون في أمر هذه البيعة أيضاً: إنّ معاوية أمر عمّاله بأنْ يبعثوا الوفود إليه من الأمصار، فلمّا اجتمعت الوفود عنده، قام معاوية بعمل خطّة لمبايعة يزيد، فاتّفق مع الضحاك بن قيس الفهري، وقال له:
«إنّي متكلّم، فإذا سكتّ فكنْ أنت الذي تدعو إلى بيعة يزيد وتحثّني عليها[292].
«فلمّا جلس معاوية للناس تكلّم فعظّم أمر الإسلام، وحرمة الخلافة وحقّها وما أمر الله به، من طاعة ولاة الأمر، ثمّ ذكر يزيد وفضله، وعلمه بالسياسة، وعرّض ببيعته، فعارضه الضحّاك فحمد الله وأثني عليه، ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إنّه لا بدّ للناس من والٍ بعدك، وقد بلونا الجماعة والألفة، فوجدناهما أحقن للدماء، وأصلح للدهماء، وآمن للسبل، وخيراً في العاقبة والأيام عوج رواجع، والله كلّ يوم هو في شأن، ويزيد ابن أمير المؤمنين في حسن هديه، وقصد سيرته على ما علمت، وهو من أفضلنا علماً وحلماً، وأبعدنا رأياً، فولِّه عهدك، واجعله لنا علماً بعدك، ومفزعاً نلجأ إليه ونسكن في ظلّه![293].
كما أنّ معاوية لمّا أراد البيعة، ليزيد دعا أهل الشام إلى اختيار خليفة من بعده، فأصفقوا واجتمعوا، وقالوا: رضينا عبد الرحمن بن خالد، فشقّ ذلك على معاوية، وأسرّها في نفسه.
ثمّ مرض عبد الرحمن، فأمر معاوية طبيباً يهودياً عنده ـ وكان عنده مكيناً ـ أنْ يأتيه فيسقيه سقية يقتله بها، فأتاه فسقاه فانحرق بطنه، فمات.
وقام بعد ذلك أخوه المهاجر بن خالد بدخول دمشق متخفّياً، وقتل الطبيب اليهودي ليلاً عند خروجه من معاوية، وقد نقل ابن عبد البر هذه القصّة، وقال بعدها: «وقصّته هذه مشهورة عند أهل السير والعلم بالآثار، والأخبار اختصرناها، ذكرها عمر بن شبّة في أخبار المدينة وذكرها غيره[294].
وأخرج خليفة بن خيّاط، قال: «حدّثنا وهب قال: حدّثني أبي، عن أيوب، عن نافع، قال: خطب معاوية، فذكر ابن عمر، فقال: والله، ليبايعنّ أو لأقتلنه[295].
إلّا أنّ معاوية معروف بسياسته وخداعه، فبعد أنْ هدّد بالقتل حاول لاحقاً إنكار ذلك، فحين دخل مكّة وقال له عبد الله بن صفوان: «أنت الذي تزعم أنّك تقتل ابن عمر إن لم يبايع لابنك؟ فقال: «أنا أقتل ابن عمر؟! إنّي والله لا أقتله[296].
كما أنّ معاوية وتمهيداً لإعلان بيعة يزيد قام بقتل الإمام الحسن× والصحابي سعد ابن أبي وقاص، لما يشكّله وجود هذين الشخصين حاجزاً كبيراً دون تحقيق ما يريد، فسعد من الستّة الذين رشّحهم عمر للخلافة، والإمام الحسن× هو الخليفة الخامس، وقد اشترط على معاوية أنْ لا يعهد لشخص آخر، وأن تعود الخلافة إليه.. لذا كان لا بدّ من التخلّص منهما، ثمّ المباشرة بأمر البيعة، يقول أبو الفرج: «وأراد معاوية البيعة لابنه يزيد، فلم يكن شيء أثقل من أمر الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص فدسّ إليهما سُمّاً، فماتا منه[297].
إذن؛ اتّضحت معالم الطريقة التي بُويع بها يزيد وليّاً للعهد، وخليفةً للمسلمين بعد معاوية، ويمكن أنْ نلاحظ على جميع ما تقدّم ما يلي:
1 ـ عرفنا فيما سبق أنّ خلافة معاوية لم تحضَ بالشرعية؛ إذ إنّه كان باغياً على إمام زمانه الإمام عليّ، ثمّ الإمام الحسن، وقد وصل للسلطة بشـروط معيّنة لكنّه لم يفِ بها، فحكومته إنّما كانت قائمة بقوة السيف، فالواجب الشـرعي عليه هو التنحّي وإعادة الحقّ إلى أهله، لا أنْ يقوم بتنصيب غيره للخلافة، فهو يفتقر للشرعية بنفسه، فضلاً عن تنصيبه خليفة من بعده.
2ـ إنّ ولاية العهد بدعة ابتدعها معاوية، لم يسبق لها غيره، فلم يحصل في تنصيب الخليفة الأوّل، ولا الثاني، ولا الثالث، ولا الرابع، أنّ الخليفة الفعلي يجعل له في حياته وليّاً للعهد، ويأخذ له البيعة بأساليب وطرق ملتوية، ثمّ يتسنّم زمام الأُمور بعد وفاته، خصوصاً أنّ وليّ العهد إنّما هو ابنه مع وجود غيره ممّن هم أفضل منه من الصحابة وأبنائهم.
فولاية العهد من المنظور الشـرعي فاقدة للشـرعية؛ لعدم وجود الدليل عليها، وعدم خضوعها لا لنظرية النص التي يقول بها الشيعة، ولا لنظرية الشورى التي يتبنّاها أهل السنّة.
ولعلّ ابن الزبير أشار إلى عدم شرعية ولاية العهد بقوله لمعاوية: «إنْ كنْت قد مللت الإمارة فاعتزلها، وهلم ابنك فلنبايعه، أرأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيّكما نسمع؟ لأيّكما نطيع؟ لا نجمع البيعة لكما والله أبداً[298].
فإنّ ما جرى هو عملية تحويل الخلافة الإسلامية إلى توريث وحكم لبني أُميّة، وهذا ما بيّنه عبد الرحمن بن أبي بكر لمروان حينما قال له: تريدون أنْ تجعلوها هرقلية، كلمّا مات هرقل قام هرقل، وفي لفظ: إنّها سنّة هرقل وقيصر، إشارة إلى حكم الروم المتمثّل بالتوريث.
ولكن قد يُقال بإنّ ولاية العهد عبارة عن ترشيح ليس إلّا، فليس هناك منصب ليزيد في حياة أبيه حتى تكون بدعة، بل هو ترشيح لولده للخلافة من بعده، والأمر للأُمّة إن قبلت فبه، وإلّا فلهم حقّ اختيار خليفة غيره عليهم.
وفي هذا يقول أبو يعلى: «ويجوز للإمام أنْ يعهد إلى إمامٍ بعده، ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحلّ والعقد... ولأنّ عهده إلى غيره ليس بعقد للإمامة؛ بدليل أنّه لو كان عقداً لها لأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصرٍ واحد، وهذا غير جائز، وإذا لم يكن عقداً لم يعتبر حضورهم، وكان معتبراً بعد موت الإمام العاقد... لما بيّنا أنّ إمامة المعهود إليه غير ثابتة مادام العاهد باقياً إماماً، ويجوز أن يعهد إلى مَن ينتسب إليه بأُبوة أو بُنوّة، إذا كان المعهود له على صفات الأئمّة؛ لأنّ الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس العهد، وإنّما تنعقد بعهد المسلمين... ويكون ذلك بعد موت المولى[299].
لكن هذا الكلام لا ينطبق على يزيد بن معاوية؛ لما سيأتي من أنّه بمجرّد موت معاوية، تسنّم يزيد أُمور الخلافة، وكتب يطلب البيعة ممَّن لم يبايعه، وهذا يكشف أنّ المسألة لم تكن عبارة عن ترشيح فقط؛ لأنّ المرشّح لا يحقّ له إجبار الناس على بيعته، قبل أنْ يكون خليفة، فاللازم بعد موت معاوية أنْ يجتمع أهل الحلّ والعقد ويجدّدوا البيعة ليزيد ـ إنْ كانوا بايعوا سابقاً ـ ثمّ بعد ذلك يصير خليفة، لكنّ ذلك لم يحصل.
3ـ إنّ
الولاية المذكورة إنّما كانت خديعة قام بها المغيرة من أجل بقائه والياً على
الكوفة، وقد أعجبت فكرته معاوية، فسعى بكلّ الوسائل والسبل لإنجاحها، فلم تكن
ناشئة من مصلحة للأُمّة كما يحاولون تبريرها، خصوصاً أنّهم يرون أنّ النبي مات ولم
ينصب شخصاً على الأُمّة، مع أنّ الأُمّة كانت تمرّ بمخاطر عدّة، وهم يُبيّنون
أهميّة السقيفة، باعتبارها انعقدت سريعاً والنبيّ لمّا يُقبر، لمواجهة مخاطر
الأُمة التي تُحيط بها؛ لذا فهم يصوّرون حنكة وسياسة معاوية حينئذٍ أفضل من حنكة
وسياسة النبيّ ـ نستجير
بالله ـ ، فالنبيّ’ مات ولم يوصِ، لكن معاوية لم يستطع أنْ يترك الأُمّة تائهة
مفكّكة، فعيّن ولده خليفة عليهم. وهذا المعنى لا يمتّ للواقع بصلة، وإليه أشار عبد
الرحمن بن أبي بكر فيما تقدّم من قوله: ما الخير أردتما لأُمّة محمّد...
4ـ إنّ الممارسات التي اتّبعها المغيرة ومعاوية في سبيل تمهيد خلافة يزيد، من الإغراء بالمال، والتخويف والترهيب، والكذب على الناس، لا تكسب يزيد الشرعية؛ لأنّ البيعة لا بدّ أنْ تتمّ وفق رضا وقناعة المبايعين.
5ـ إنّ أعيان الأُمّة رفضوا هذا التنصيب، وعلى رأسهم الحسين بن علي×، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وبيّنوا وجهة نظرهم بصورة واضحة وصريحة، وأنّ يزيد لا يصلح للخلافة. وفي قول بعضهم كما تقدّم: إنّ هذه هرقلية، ووراثة في الخلافة، أسّس لها معاوية.
لذا؛ فالبيعة بولاية العهد فاقدة للسند الشـرعي أوّلاً، ولم تتمّ على الأرض ثانياً، فلا حجّية لها إذاً.
ونختم هذا المبحث بما صرّح به الشيخ رشيد رضا حول موضوع البيعة، فقد ذكر أنّ استخلاف معاوية ليزيد ـ وعبّر عنه بالفاسق الفاجر ـ كان بقوة الإرهاب من جهة، ورشوة الزعماء من جهةٍ أُخرى، وأوضح أنّ هذا الاستخلاف تلته سنّة سيّئة من احتكار أهل الجور والطمع في السلطان، وجعله إرثاً لأولادهم أو لأوليائهم كما يورث المال والمتاع؟ وإنّ هذه أعمال عصبية القوة القاهرة المخالفة لهدي القرآن، وسنّة الإسلام[300].
وقال أيضاً: «أخذ معاوية البيعة لابنه الفاسق يزيد بالقوة والرشوة، ولم يلقَ مقاومة تذكر بالقول أو الفعل إلّا في الحجاز. ثمّ ذكر الرواية الدالّة على معارضة عبد الرحمن بن أبي بكر وما جرى بينه وبين مروان، وأضاف: «ثمّ حجّ معاوية ليوطّئ لبيعة يزيد في الحجاز، فكلّم كبار أهل الحلّ والعقد أبناء أبي بكر، وعمر، والزبير، فخالفوه وهدّدوه إن لم يردّها شورى في المسلمين، ولكنّه صعد المنبر، وزعم أنّهم سمعوا وأطاعوا وبايعوا يزيد، وهدّد مَن يكذّبه منهم بالقتل.
وأخرج الطبراني من طريق محمد بن سعيد بن زمانة أنّ معاوية لمّا حضـرته الوفاة قال ليزيد: قد وطّأت لك البلاد، ومهّدت لك الناس، ولست أخاف عليك إلّا أهل الحجاز، فإن رابك منهم ريب فوجّه إليهم مسلم بن عقبة، فإنّي قد جرّبته وعرفت نصيحته. قال: فلمّا كان من خلافهم عليه ما كان، دعاه فوجّهه فأباحها ثلاثاً...
وأخرج أبو بكر بن خيثمة بسندٍ صحيح إلى جويرية بن أسماء: سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدّثون أنّ معاوية لمّا احتضر دعا يزيد، فقال له: إنّ لك من أهل المدينة يوماً، فإن فعلوا فارمِهم بمسلم بن عقبة، فإنّي عرفت نصيحته الخ.
ذكره الحافظ في الفتح: أباح عدو الله مدينة الرسول ثلاثة أيام، فاستحق هو وجنده اللعنة العامّة في قوله [صلّى الله عليه وسلّم] عند تحريمها كمكة، مَن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً (أي فرضاً ولا نفلاً) ـ متّفق عليه ـ فكيف بمَن استباح فيها الماء والأعراض والأموال؟!
وكان الحسن البصري يقول أفسد الناس اثنان: عمرو بن العاص يوم أشار على معاوية برفع المصاحف، وذكر مفسدة التحكيم، والمغيرة بن شعبة، وذكر قصته إذ عزله معاوية عن الكوفة فرشاه بالتمهيد لاستخلاف يزيد فأعاده.
قال الحسن: فمن أجل هذا بايع هؤلاء الناس لأبنائهم، ولولا ذلك لكانت شورى إلى يوم القيامة[301].
اتّضح في المبحث السابق أنّ معاوية نصّب يزيد وليّاً لعهده، وعرفنا أنّ ولاية العهد بدعة أحدثها معاوية، لم يسبق لها أحد غيره، وأنّها مخالفة لنظرية النص ونظرية الشورى.
غير أنّه قد قِيل: إنّ التكييف الشرعي لولاية العهد أنّها ترشيح الشخص للخلافة، لتبايعه الأُمّة بعد ذلك برضاها، فإنْ بايعته انعقدت له الإمامة، وإنْ رفضت بيعته أو بايعت غيره سقط الترشيح السابق له، وكأنّه لم يكن، وبهذا تبقى الأُمّة هي صاحبة القول الفصل في اختيار الحاكم[302].
وقد تقدّم منا ذكر قول أبي يعلى في أنّ الإمامة لا تتحقّق بالعهد، بل لا بدّ من بيعة المسلمين للمعهود له بعد وفاة الخليفة الفعلي.
وعلى ضوء ذلك سنقف قليلاً مع بعض المباحث؛ لنرى شرعية البيعة أوّلاً، ثمّ شرعية بيعة يزيد على وجه الخصوص.
(i) 1ـ عدم وجود نصٍّ على شرعية البيعة
أشرنا عند التعرّض لمبحث السقيفة أنّه لم يتحقّق في بيعة أبي بكر لا إجماع الأُمّة ولا أهل الحلّ والعقد، وقد تخلّف عن بيعته كثير من الصحابة، وعلى رأسهم عليّ بن أبي طالب×، بل إنّ عامّة بني هاشم لم يبايعوا، وذكرنا سابقاً ثلّة من الصحابة المتخلّفين عن بيعة أبي بكر، وألمحنا هناك إلى أنّه لم يتبيّن في السقيفة استنادهم إلى نصٍّ شرعي، سواء من القرآن او السنّة، بل كانت اجتهادات شخصية، هدفها الاستيلاء على السلطة فقط، ولذا وقعت الخلافات، واجتمع الأنصار سرّاً في سقيفة بني ساعدة، وحين علم أبو بكر وعمر بالخبر أقبلوا إليهم مسرعين، مصطحبين معهم أبو عبيدة. وعليّ، وبنو هاشم مشغولون بتجهيز النبيّ’، فلو كانت مسألة الشورى مستندة إلى نصٍّ شرعي، فلا معنى لاجتماع الأنصار بصورة سريّة لاختيار خليفة للمسلمين، ولا معنى لفزع أبي بكر وعمر إلى السقيفة، من دون مشاورة بني هاشم وإعلامهم بالخبر، فلا الأنصار شاوروا قريشاً والمهاجرين، ولا أبو بكر وعمر شاور بني هاشم، ولا ما حصل في السقيفة كان شورى بين المسلمين، بل طفت على السطح العصبية والقبلية، وكلّ فريق يطمع في الخلافة، والخلاصة أنّ السقيفة لم تستند في عملها إلى النّص الشـرعي، لا من القرآن ولا من السنّة، والذين اشتركوا فيها لم يستشيروا غيرهم، والنتيجة التي حصلت أنّ البيعة لم تتمّ لا بإجماع الأُمّة، ولا إجماع أهل الحلّ والعقد.
وما يؤكّد عدم وجود نصٍّ شرعي تستند له السقيفة، وإنّها كانت اجتهادات، الغرض من ورائها الحصول على الملك والسلطان، ما قام به أبو بكر من تنصيب عمر بن الخطاب خليفةً على المسلمين من دون رضا الصحابة، ثمّ أكمل عمر مشوار التخبّط في اختيار الخليفة، فجعلها من بعده شورى في ستّة، على أنْ ترجّح الكفّة التي يكون فيها عبد الرحمن ابن عوف.
إذاً؛ لم تكن هناك شورى في تنصيب أبي بكر، ولا في تنصيب عمر، ولا في تنصيب عثمان، واختلفت الطرق في ذلك؛ لذا اضطرب أهل السنّة في هذا الأمر، خصوصاً بعد رفضهم نظريّة النصّ، فراحوا ينظّرون ويشرعنون للواقع الخارجي الذي حصل، فأهل السنّة لم ينطلقوا من الكتاب والسنّة لمعرفة الطرق الشرعية لتولّي الخلافة، بل انطلقوا من الواقع الخارجي، واعتبروه واقعاً شرعيّاً، وأخذوا ينظّرون له ويبيّنون الأدلّة عليه، مع أنّه واقع متناقض مضطرب.
والذي دعا أهل السنّة لذلك هو قولهم بنظرية عدالة الصحابة أجمع، وأنّهم من أهل الجنّة، وطبقاً لذلك راحوا يتأوّلون لأعمالهم، ويبرّرونها بشتّى الوسائل، فجمعوا بين المتناقضات، فيرون أنّ عليّاً من أهل الجنّة، وعمار بن ياسر من أهل الجنّة، وفي المقابل فإنّ معاوية وأصحابه الذين قاتلوا عليّاً وقتلوا آلاف المسلمين في حرب صفّين من أهل الجنّة أيضاً، والغريب أنّهم ينقلون في صحيح البخاري، أنّ النبيّ قال: «ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله [وفي لفظٍ إلى الجنة] ويدعونه إلى النار[303].
ولم يَدرْ في خلد مسلم أبداً كيف أنّ الداعي إلى النار والداعي إلى الجنّة يكونان في الجنّة معاً، خصوصاً أنّهم دخلوا في قتال مرير راح ضحيّته الآلاف، والأغرب من ذلك أنّ النبيّ’ صرّح بأنّ قاتل عمّار وسالبه في النار[304]، مع أنّ الذي قتل عماراً هو صحابي آخر، يُدعى أبو الغادية الجهني![305].
والغرض أنّ القرآن والسنّة والواقع التأريخي تُبيّن بوضوح أنّ بعض الصحابة انحرف عن الحقّ ولابس الفتن، ولا يمكن المصير إلى القول بعدالة كلّ صحابي مهما فعل ومهما ارتكب من مخالفات شرعية.
فأهل السنّة انطلقوا من واقع هو بنفسه بحاجة إلى مستندٍ شرعي لتصحيحه، واتّخذوه سنداً شرعياً لهم، حتى أنّ بعضهم قال بكفاية انعقاد الإمامة ببيعة واحد من أهل الحلّ والعقد، بل جعلوا التغلّب بقوة السيف أحد طرق تولّي الإمامة، وهو قول يرفضه الوجدان السليم، فالخارج على الحاكم الشرعي فاسق شاقّ لعصا المسلمين، ويقولون بوجوب قتله، لكنّه لو انتصـر صار خليفة للمسلمين، وتجب طاعته، فسبحان الله كيف يتحوّل مهدور الدم إلى إمام للمسلمين!
ونحن هنا نكتفي بذكر كلمات حول طرق انعقاد الإمامة؛ ليتّضح جيّداً كيف أنّهم اتخذوا الواقع الخارجي دليلاً لهم، ولم يعرضوا الواقع الخارجي على القرآن والسنّة، فقد أوضح النووي أنّ الإمامة تنعقد بثلاثة طرق، قال: «أحدها: البيعة، كما بايعت الصحابة أبا بكر (رضي الله عنهم)، وفي العدد الذي تنعقد الإمامة ببيعتهم ستّة أوجه:
أحدها: أربعون. والثاني: أربعة. والثالث: ثلاثة. والرابع: اثنان. والخامس: واحد...
والسادس وهو الأصحّ: إنّ المعتبر بيعة أهل الحلّ والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسّر حضورهم...[306].
فالأصل في شرعية البيعة هو مبايعة الناس لأبي بكر، ولم يستند النووي لآية أو رواية في الموضوع، كما أنّ أكثر الأعداد التي ذكرها النووي قد استندوا فيها إلى الواقع الخارجي، فمثلاً قالوا بكفاية الواحد؛ لاكتفاء الصحابة بواحد استناداً لعقد عمر لأبي بكر، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا اجتماع مَن في المدينة فضلاً عن إجماع الأُمّة، ولم ينكر عليهم أحد[307]، وكفاية الخمسة؛ لأنّ بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثمّ تابعهم الناس، وهم: عمر بن الخطّاب، وأبو عبيدة، وأُسيد بن خضير، وبشر بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة، ولأنّ عمر جعل الشورى في ستّة؛ ليعقد لأحدهم برضا الخمسة[308].
والطريق الثاني الذي ذكره النووي لانعقاد الإمامة هو: «استخلاف إمام من قَبلُ وعهده إليه، كما عهد أبو بكر إلى عمر (رضي الله عنهما)، وانعقد الاجماع على جوازه[309].
لكنّ الإجماع الذي ذكره محلّ نظر؛ فإنْ كان مقصوده إجماع الصحابة على قبوله، فغير تام؛ إذ إنّ الصحابة لم يرضوا بذلك كما قدّمنا سابقاً، وإنْ كان يقصد الإجماع المتأخّر عن ذلك التنصيب من قبل الفقهاء، فإنّما هو إجماع مستنِد إلى ذلك الفعل، وذلك الفعل بنفسه محتاج إلى المشروعيّة، فلا يكتسب الحجيّة.
والطريق الثالث الذي ذكره النووي هو: «القهر والاستيلاء، فإذا مات الامام، فتصدّى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة، وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته؛ لينتظم شمل المسلمين[310].
والحقيقة أنّ العلّة الحقيقية ليست انتظام شمل المسلمين، إنّما هو تصحيح الحكومات السنيّة، من زمن معاوية فما بعدها، القائمة على الغلبة والسيف والقهر، وهذه الطريقة لعقد الإمامة ـ كما اسلفنا ـ تحوّل مهدور الدم، الشاقّ لعصا المسلمين إلى خليفةٍ مطاع، وينهار معها تشـريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأُمّة طِبق هذا الطريق عليها الخضوع للحاكم، رغم انحرافه واستهتاره بالشريعة، وإذا كانت الأُمّة ساكتة عنه، وهو منحرف أيضاً، فمَن سيطبّق أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أفراد المجتمع الإسلامي، وهكذا فإنّ الرضا والسكوت على هكذا حاكم يُودي بالأُمّة إلى هوةٍ سحيقة، ويبعدها عن دينها وشريعتها السمحاء، وتتحوّل الأُمّة إلى مجموعة عبيد، يقودهم السلطان كيفما يشاء، وهذا ما حصل في زمن يزيد بن معاوية.
والخلاصة التي نخرج بها ممّا تقدّم: إنّه لا يوجد نصّ شرعي من القرآن والسنّة يبيّن طرق تولّي الإمامة عند أهل السنّة، وما حاولوا بيانه لاحقاً من الاحتجاج ببعض الآيات أو الروايات إنّما كان هدفه شرعنة ما قام به الصحابة ومَن بعدهم، مع أنّ الصحابة ومَن بعدهم لم يقوموا بذلك وفق تلك الأدلّة، كما أشرنا فيما سبق.
على أنّ ما ساقوه من أدلّة غير تام في نفسه، خصوصاً أنّ تولّي الإمامة لها عدّة طرق، وغير محصورة بالشورى كما عرفنا، وتلك الأدلّة قد أُشبعت بحثاً، وناقشها العلماء، ولا نرى ضرورة لذكرها هاهنا، بعد أنْ أوضحنا للقارئ أنّ المُستند الأساس هو العمل الخارجي لا غير.
واتّضح من جميع ما تقدّم؛ أنّ البيعة لم تستند إلى أساس شرعي يمكن الاعتماد عليه، ومعه تكون الحكومات القائمة على هذا الأساس هي حكومات غير شرعية.
(ii) 2ـ البيعة لم تتحقّق خارجاً
أوضحنا سابقاً بأنّ ولاية العهد ـ بمعنى تنصيب الخليفة اللاحق في زمان حكم الخليفة الفعلي ـ هي بدعة اخترعها معاوية، وأنّه استخدم الرشاوى من جهة، والترهيب والتهديد والخدعة من جهةٍ أُخرى في تحصيل تلك البيعة، على أنّ أعيان أهل المدينة لم يبايعوا، وأكثر الناس الذين بايعوا إنّما انخدعوا بقول معاوية بحصول البيعة له من رؤساء أهل المدينة ووجهائها؛ لذا فإنّ تلك البيعة لم تحضَ بشـرعية القبول؛ لأنّ البيعة الشـرعية ـ لو قبلناها ـ فإنّما هي تلك الصادرة عن رغبة أهل الحلّ والعقد وإرادتهم، حسب تشخيصهم لواقع المجتمع، لا أنْ تُملى عليهم بالقهر والقوة، والحِيَل الماكرة.
وقد عرفنا أنّ هناك توجيهاً وتكييفاً فقهياً لموضوع ولاية العهد، يُفذلك ولاية العهد على أنّها ترشيح للخلافة لا غير، وهذا الترشيح منوط تحقّقه خارجاً برأي الأُمّة، فإنْ بُويع من قِبَل أهل الحلّ والعقد بعد وفاة الخليفة، صار هو الخليفة الفعلي، وإنْ بايعت الأُمّة غيره سقط الترشيح، وصار هذا الشخص المبايَع هو الخليفة الفعلي.
وحينئذٍ يتسنّى لنا التساؤل، بأنّه ما المقصود من أنّ البيعة حصلت ليزيد؟ هل المراد هي تلك البيعة التي أخذها له أبوه معاوية؟ أو بيعةٌ أُخرى؟
فإنْ كان المقصود هي تلك البيعة التي أخذها له أبوه معاوية، فهي لم تحضَ بالشرعية؛ لأُمور:
أوّلاً: إنّها كانت مبتنية على المكر والخديعة والتهديد والترهيب والرشاوى، مع أنّ نفس أخذ البيعة بوجود السلطان يخرجها عن حياديتها؛ لما للسلطان من تأثير كبير على ميولات الناس، فكيف إذا استخدم نفوذه وقوته في ذلك، فالبيعة لم تكتسب المشروعية من تلك الجهة.
ثانياً: إنّ البيعة لم تتمّ خارجاً؛ لأنّ أعيان أهل المدينة لم يبايعوا، وعلى رأسهم الحسين ابن علي×، وعبد الله بن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وعبد الله بن عمر.
ثالثاً: إنّها بيعة في حياة الخليفة الفعلي، فليست مُلزِمة للناس بعد وفاته؛ لأنّ اللازم هو مبايعة الخليفة عند وفاة الخليفة السابق، ليتسنّم بعدها منصب الخلافة، وتجب على الناس طاعتُه، وأمّا البيعة في حياة الخليفة فلا تعني شيئاً إطلاقاً، ما دام المُبايَع له لا تجب طاعته، وهذا ما صرّح به ابن الزبير بقوله: «إنْ كنْت قد مللت الإمارة فاعتزلها، وهلم ابنك فلنبايعه، أرأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيّكما نسمع؟ لأيّكما نطيع؟ لا نجمع البيعة لكما والله أبداً[311].
فالبيعة تلك إنّما كانت بجعل يزيد وليّاً للعهد، وولاية العهد لا تعني سوى الترشيح ـ على ما أشرنا سابقاً ـ والمرشّح لا يكتسب الشـرعية إلّا بالبيعة له بالخلافة عند موت الخليفة الفعلي.
وإنْ كان المقصود من البيعة هي بيعة أُخرى حصلت ليزيد بعد وفاة معاوية، فهذا ما لم نقف عليه في كتب التاريخ، فإنّ المؤرّخين يذكرون البيعة التي أخذها له معاوية بصورة مفصّلة، لكنّهم حين يذكرون وفاة معاوية وتاريخه، يذكرون بعده أنّه بُويع ليزيد بالخلافة من بعده، والظاهر أنّ مرادهم من ذلك هو مراسم تسلّم يزيد للسلطة، لا أنّها بيعةٌ أُخرى حضرها أهل الحلّ والعقد، خصوصاً أنّها حصلت بعد وفاة معاوية فوراً، فالظاهر أنّه تولى الخلافة اعتماداً على بيعته بولاية العهد السابقة؛ لذا كان أوّل عمل قام به هو طلب البيعة من الحسين×، وابن الزبير، وابن عمر، من دون رخصة في ذلك، فكان همّه إنّما أخذ البيعة من الذين لم يبايعوه سابقاً، ولم نجد من المؤرّخين مَن يذكر أنّ أهل الحلِّ والعقد اجتمعوا وقرّروا اختيار يزيد خليفة للمسلمين بعد معاوية، خصوصاً أنّه تولّى الحكم في الشام تبعاً لمقرّ أبيه، والشام تُعتبر حاضنة لبني أُميّة، ومليئة بالنواصب لأهل البيت^، فلا يمكن أنْ نعدّ بيعتهم ـ لو حصلت ـ بيعةً شرعية، ملزمة للمسلمين في جميع الأقطار.
والغرض أنّ تصرّفات يزيد لا تدلّ على وجود بيعة جديدة، بل كان أقصـى ما يريده توطيد ملكه الجديد، ولو بقتل مَن لم يبايعه في حياة أبيه، قال الطبري وابن الأثير ـ واللفظ للثاني ـ: «فلمّا تولّى [يعني يزيد] كان على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وعلى مكة عمرو بن سعيد بن العاص، وعلى البصـرة عبيد الله بن زياد، وعلى الكوفة النعمان بن بشير، ولم يكن ليزيد همّة حين ولي إلّا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته، فكتب إلى الوليد يخبره بموت معاوية، وكتابا آخر صغيراً فيه: أمّا بعد، فخذ حسيناً، وعبد الله بن عمر، وابن الزبير بالبيعة أخذاً ليس فيه رخصة حتّى يبايعوا، والسلام[312].
ولا يتصوّر القارئ أنّ هؤلاء الثلاثة فقط لم يبايعوا، بل إنّ كلاًّ من هؤلاء له أقارب وأتباع لم يغترّوا بخدعة معاوية، ولم يبايعوا أيضاً، فقد نقل البلاذري عن أبي مخنف وأبي عوانة وغيرهم، أنّه لما بُعث إلى الحسين وابن الزبير يدعونهما إلى البيعة: «فأمّا الحسين فامتنع بأهل بيته ومَن كان على رأيه، وفعل ابن الزبير مثل ذلك[313].
ثمّ إنّ نفس الرسائل التي وصلت للإمام الحسين× من أهل العراق تؤكّد أنّهم لم يبايعوا ليزيد بن معاوية، وأنّهم من دون إمام، فقال× في جوابه لعمر بن سعد: «إنّ أهل هذا المصـر كتبوا إليّ يذكرون أن لا إمام لهم، ويسألونني القدوم عليهم[314].
ومن رسائلهم له×: «أمّا بعد، فالحمد لله الذي قصم عدوّك الجبار العنيد، الذي انتزى على هذه الأُمّة فابتزها أمرها، وغصبها فيأها، وتأمّر عليها بغير رضًى منها، ثمّ قتل خيارها، واستبقى شرارها، وجعل مال الله دولةً بين جبابرتها وأغنيائها، فبُعداً له كما بعدت ثمود، إنّه ليس علينا إمام، فأقبِلْ لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد، ولو قد بلَغنا أنّك قد أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشام إن شاء الله، والسلام ورحمة الله[315].
والخلاصة: إنّه إنْ كان المراد من البيعة هي تلك التي حصلت في حياة أبيه فهي لم تتحقّق بشروطها على الخارج، لا من جهة الاختيار والإرادة، ولا من جهة أهل الحلّ والعقد، وإن كان المراد من البيعة هي التي كانت بعد وفاة أبيه، فهي لم تحصل بالأساس.
نعم، بعد أنْ تسنّم يزيد الخلافة بصورة رسمية، راح ولاته يأخذون البيعة له في الأمصار المختلفة، وهذه بيعة إنْ تمّت في بعض المناطق فهي متأخّرة عن تولّيه للخلافة، ولم تكن بيعة تولّى بموجبها يزيد للخلافة، فهي بيعة تحت تأثير السلطة، ويعاقب كلّ من يتخلّى عنها، ولو أدّى ذلك إلى القتل، ومع ذلك فهي لم تحصل في جميع المناطق، وخالفها ثلّة من أهل الحلّ والعقد، كما ذكرنا سابقاً.
وما يؤكّد ذلك أيضاً أنّ الرسل كانت «تجرى بين يزيد بن معاوية، وابن الزبير في البيعة، فحلف يزيد أن لا يقبل منه حتّى يُؤتى به في جامعة، ثمّ إنّ يزيد أمر بإرسال جيش لقتال ابن الزبير، فأُرسل عمرو بن الزبير إلى المدينة، وكان على خلاف مع عبد الله بن الزبير، فـ «نظر إلى كلّ مَن كان يهوى هوى ابن الزبير فضـربه، وكان ممَّن ضرب: المنذر بن الزبير، وابنه محمّد بن المنذر، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام، وخبيب بن عبد الله بن الزبير، ومحمّد بن عمّار بن ياسر، فضـربهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين، وفرّ منه عبد الرحمن بن عثمان، وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل في أُناسٍ إلى مكة[316].
ويترتّب على ذلك أنّه مضافاً لعدم تحقّق شروط ومواصفات الخليفة في شخص يزيد، فإنّ البيعة أيضاً لم تحصل له على الوجه المطلوب، فيبقى غاصباً للخلافة، غير مستحقٍّ لها، ويجوز الخروج عليه إحقاقاً للحقّ، ودفعاً للباطل، خصوصاً أنّ خلافته تمثّل تحوّلاً جذرياً في مسار الأُمّة، وتأسيساً لمشـروع التوريث في الخلافة، من دون مراعاة أيّة شرائط وضوابط في ذلك، وقد روى أهل السنّة ما يؤكّد ذلك، فقد أخرجوا عن سفينة، عن النبيّ’، أنّه قال: «الخلافة ثلاثون سنة، ثمّ تصير ملكاً. قال ابن حجر: «أخرجه أصحاب السنن، وصحّحه ابن حبان وغيره[317].
وقد صرّحوا بأنّ الثلاثين سنة تنتهي بانتهاء الفترة التي تولّى فيها الإمام الحسن× الخلافة، فتكون الفترة اللاحقة من تسلّط معاوية، ثمّ يزيد على الأُمّة هي ملكٌ عضوض، وليست خلافة إسلامية.
مشروعية حكم يزيد في ضوء القوانين الوضعية
من الواضح الجلي أنّ الحكومات في القوانين الوضعية تخضع لشـروط معيّنة، فرئاسة الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، أو أفراد البرلمان، لا بدّ أنْ يتمتّعوا بمواصفات وشرائط، حتّى يتمكنّوا من نيل الصفة الرسمية للمنصب الذي يترشّحون له، فمن هذه الشـرائط مثلاً ـ على بعض القوانين ـ أنْ يكون رئيس الوزراء أو الجمهورية متولّداً من أبوين يحملان جنسية نفس البلد، وكذلك أن يحملان شهادة معيّنة، كأنْ تكون البكلوريوس مثلاً، وهكذا توجد عدّة شرائط لا بدّ من تحقّقها عند المرشّح، ومن دونها يعتبر ترشيحه لاغياً، ولو خالف الواقع واستطاع تزوير بعض المستمسكات؛ كي تتحقّق به الشـرائط، فسيُقال من منصبه، ويتعرّض للمحاكمة من قِبَل محكمة البلد عند اكتشافها لذلك.
ومن باب المثال على ذلك، فإنّ دستور الولايات المتحدّة الأمريكية ينصّ في المادة الثانية، الفقرة الأُولى على أنْ «تُناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل الرئيس منصبه مدّة أربع سنوات، ويتمّ انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يُختار لنفس المدّة.... ثمّ يشـرع الدستور ببيان طريقة انتخاب الرئيس، وبيان الشرائط في ذلك، في عدّة نقاط، نقتصر على ذكر النقطة برقم (5)، حيث جاء فيها: «لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة، أو مَن يكون من مواطني الولايات المتحدّة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهّلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهّلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين، ولم يكن مقيماً في الولايات المتحدة مدّة أربعة عشر عاماً.
وينصّ القانون المصـري لسنة 1971م، في المادة 75، بأنّه: «يُشترط فيمَن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصـرياً، من أبوين مصـريين، وأن يكون متمتّعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألّا تقل سنّه عن أربعين سنة ميلادية.
وينصّ في المادة 76، على أنّه: «يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرّى العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يُؤيّد المتقدّم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسـي الشعب والشورى، والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألّا يقل عدد المؤيّدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كلّ مجلس شعبى محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل، ويزداد عدد المؤيّدين للترشيح من أعضاء كلّ من مجلسي الشعب والشورى، ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات، بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أيّ من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشّح، وينظّم القانون الإجراءات الخاصّة بذلك كلّه.
والغرض أنّ المرشّح لرئاسة الجمهورية في الدساتير الوضعية له شرائط ومواصفات خاصّة، وإن اختلفت هذه الشـرائط والمواصفات من دستورٍ إلى آخر، إلّا أنّها اتّفقت على أنّه لا يمكن لأيٍّ كان أنْ يكون رئيساً للبلد، ما لم تنطبق عليه عدّة من المواصفات والشرائط.
وكما أنْ المرشّح لا بدّ أنْ تتحقّق فيه عدّة من المواصفات، فكذلك طريقة الانتخاب لها عدّة من الشرائط، فمنها أنْ لا تكون الحكومة قد استخدمت المال العام في دعم مرشحها، خصوصاً إذا كان من دون هذا الدعم لا يمكن أنْ يحقّق أيّ نجاح يُذكر، ومنها أنْ تكون الانتخابات نزيهة، وأنْ لا يكون هناك تلاعب فيها، وأنْ يكون المُنتخِب ـ بكسر الخاء ـ له أهليّة الانتخاب وفق شروط ذلك البلد، كأنْ يكون بلغ الثامنة عشـرة من عمره، وغير ذلك من الشرائط، ولو حصل وإنْ فاز المرشّح من دون تحقّق هذه الشرائط، كأنْ تكون الانتخابات غير نزيهة مثلاً، أو استخدم المرّشح أساليب غير شرعية في تحصيله على الأصوات التي مكّنته من الفوز؛ فسيعتبر خاسراً، بل قد يتعرّض للمحاكمة.
وكذلك فإنّ المرشّح للبرلمان لا بدّ أنْ تتوفّر فيه عدّة شرائط، فمثلاً ينصّ قانون الولايات المتحدّة الأمريكية، المادة الأُولى، الفقرة الثانية، رقم(2)، على أنّه «لا يصبح أيّ شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشـرين، وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتّحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتمّ اختياره فيها.
وينصّ الدستور العراقي لسنة 2005م، في المادة 47، ثانياً: على أنّه «يُشترط في المرشّح لعضوية مجلس النواب أنْ يكون عراقياً كامل الأهلية، وأوكل سائر شرائط المرشّح، وشرائط الانتخاب إلى تشريعها عن طريق مجلس النواب، فقال في ثالثاً: «تنظّم بقانون شروط المرشّح والناخب وكلّ ما يتعلّق بالانتخاب.
والغرض أنّ هناك شروطاً للمرشّح نفسه، وهناك شروطاً للانتخاب وطريقته، ومخالفة تلك الشروط قد تودي بالفائز ويصبح في عداد الخاسرين، وهذا واضح معروف في القوانين المعمول بها حالياً في الكثير من البلدان، فلو فرضنا أنّ الرئيس اتُّهم بقضية معيّنة وثبتت عليه، كخيانة البلد، أوقيامه بتزوير شهادته، أو غير ذلك ممّا يعدّ مخالفة دستورية أو قانونية، فسوف يعرّض للمساءلة ولربّما للعزل، وفي هذا الصدد نستشهد بالقانون الأمريكي، المادة الثانية، الفقرة الرابعة، فهي تنصّ على أنّه: «يُعزل الرئيس، ونائب الرئيس، وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم، إذا وُجّه لهم اتّهام نيابي بالخيانة، أو الرشوة، أو أيّة جرائم، أو جُنح خطيرة أُخرى، وأُدينوا بمثل هذه التّهم....
ولو قمنا بعملية إسقاط قانوني على فترة يزيد بن معاوية، لوجدنا أنّ هناك شروطاً للمرشّح للخلافة، وكذلك شروطاً لكيفيّة البيعة.
أمّا شرائط المرشّح للخلافة فهي عديدة، وقد ذكرناها فيما تقدّم، ونذكر هنا أهمّها ملخّصاً:
1ـ العدالة.
2ـ العلم المؤدّي إلى الاجتهاد.
3ـ سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان.
4ـ الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.
5ـ الشجاعة والنجدة المؤدّية إلى حماية البيضة، وجهاد العدو.
وغير ذلك ممّا تقدّم سلفاً.
وكذلك فإنّ الانتخابات والبيعة لها شروط معيّنة، لعلّ أهمّها أنْ تكون من أهل الحلّ والعقد، وأنْ تكون برضاهم واختيارهم، وغير ذلك ممّا هو مبثوث في كلماتهم.
وبالتأمّل فيما أشرنا إليه من القوانين الوضعية، فإنّ بيعة يزيد تكون غير قانونية، لا من جهة الشرائط الذاتية، ولا من جهة طريقة البيعة، فهو لا يتمتّع بالصفات التي تؤهلّه للخلافة، خصوصاً صفتي العدالة والاجتهاد، فقد أوضحنا سابقاً بصورة مفصّلة أنّ يزيد كان يشـرب الخمر، ويترك الصلاة، وينشغل بالملذات، وكذلك لا يوجد ما يُثبت معرفته بالقرآن والسنّة، والاجتهاد فيهما، بل إنّ سيرته بعيدة كلّ البعد عن أجواء العلم والدين، وكذلك فهو لا يتّسم بحسن الرأي، الذي عن طريقه يُدير أُمور الرعيّة، ويراعي مصالحها، بل إنّ أعماله القبيحة أثبتت خلاف ذلك، والغرض أنّ يزيد لا يملك المؤهّلات والشرائط التي يجب توفّرها في الخليفة الإسلامي.
وكذلك فإنّ طريقة البيعة لم تراعَ فيها الأُصول الصحيحة، فهي لم تتمّ من أهل الحلّ والعقد، بعد أنْ رفضها ثلّة من كبار وجوه الصحابة، وأهل البيت^ في ذلك الوقت، وعلى رأسهم الحسين×، وابن الزبير، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عمر، كما أنّ الحرية لم تكن متوفّرة ليُدلي أهل الحلّ والعقد بآرائهم بحريّة تامة، فقد استُخدمت فيها أساليب التهديد، والإغراء والكذب، والخيانة، وكانت الدولة نازلة بقوة في دعم مرشحها باستخدام سلطتها وعنفوانها في ذلك.
مضافاً إلى ذلك فإنّ ما حصل في زمن معاوية غير ملزم للأُمّة؛ لأنّ البيعة يجب أنْ تكون بعد وفاة الخليفة، لا أنْ تُؤخذ في حال حياته، فهي عبارة عن ترشيح لا غير، وقد تقدّم بيان ذلك، لكنّ الذي حصل أنّه بمجرد موت معاوية تسنّم يزيد مقاليد السلطة، وأخذ يدعو الناس إلى بيعته بالقوة، فلم يقف يزيد جانباً لينتظر قرار أهل الحلّ والعقد فيمَن يرون خليفةً على المسلمين، بل تربّع على السلطة وحاول بعد ذلك أخذ البيعة بالقوة، وخصوصاً ممَّن لم يبايعوه سابقاً بولاية العهد على ما تقدّم.
فلم تتحقّق في يزيد لا شرائط الخلافة، ولا شرائط البيعة، فتكون خلافته غير قانونية وفق القوانين الوضعية أيضاً.
تبيّن ممّا سبق أنّ الخلافة الإسلامية لها شروط معيّنة، سواء ما يتعلّق بشخص الخليفة، أو بآلية بيعته وانتخابه، وخلصنا إلى أنّ يزيد بن معاوية لا يتمتّع بالصفات والمؤهّلات التي تجعله خليفة، وأنّ بيعته حصلت في حياة أبيه بالقوة والتحايل، والغدر والإغراء، ولم يبايعه ثلّة من وجهاء أهل المدينة، ومَن تبعهم من ذويهم أو ممَّن يُؤخذ برأيهم، ولم تحصل هناك بيعة صريحة وواضحة بعد وفاة معاوية، هذا فضلاً عن عدم وجود دليل على شرعية ولاية العهد، أو شرعية البيعة لتنصيب الخليفة، بل كان جلّ استنادهم في ذلك هو الواقع الخارجي، وهو مضطرب ومتناقض، وبحاجة إلى دليل يصحّحه، وليس هو دليل بنفسه.
كما اتّضح أنّه حتى وفق القوانين المعمول بها حالياً، فإنّ يزيد لا يستمدّ المشروعية لخلافته؛ لعدم انطباق القوانين عليه، سواء تلك المتعلّقة بذاته، أو الأُخرى المتعلّقة بشروط وطريقة البيعة.
ونخلص من جميع ذلك أنّ يزيد تسلّط على رقاب المسلمين، واغتصب الخلافة الإسلامية، وهو متفسّخ بعيد عن كلّ القيم والمبادئ، وبُويع له بطريقة غير مشـروعة، وشرعنت بخلافته مسألة التوريث، فكان من الضـروري الوقوف بوجه هذا التحوّل الكبير في مسار الأُمّة الإسلامية، وأصبحت كلمة (لا) الرافضة لبيعته واجبة على المسلمين؛ لإنقاذ الأُمّة من خطر فقدان الهوية، والانزلاق إلى هوّةٍ سحيقة، بعيدة كلّ البعد عن قيم ومبادئ الرسالة المحمدية، وهذا ما قام به الحسين×.صل موعيةالثورة في ضوء وجوب الأمر بالمعروف .. وضمان الحريات في القانونض
وضمان الحريات في القانون الوضعي
المبحث الأوّل
وفق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
أوضحنا سابقاً أنّ أوّل جذور الانحراف في مسار الأُمّة كان بعد وفاة النبيّ’ مباشرةً، حين أُقصيَ البيت العلوي عن الخلافة، وغُيّبت نظرية النصّ، فتسنّم حينها أبو بكر أُمور الخلافة، وبدأت الأُمور تُسيّر بخلاف ما رُسم لها، وبلغ الانحراف أشدّه حين ولي عثمان، خصوصاً أنّه قرّب بنو أُميّة، وسلّطهم على رقاب المسلمين، وتفاقمت الأوضاع، وانتهت الأُمور بثورة عارمة أطاحت بالخليفة، فأقبلت الأُمّة إلى عليّ× تطلب منه تولّي الخلافة.
تسنّم الإمام علي× مقاليد الأُمور وفق بيعة الناس له، لا وفق إيمان المجتمع بالنص، فالفترة الطويلة التي عاشها المجتمع بعيداً عن توجيهات الرسول أسهمت في تغييب نظرية النص من الأذهان، ولذا فإنّ الإمام علي× حاول في أكثر من خطبة أنْ يُعيد إلى الأذهان تنصيبه في يوم الغدير، وأولويته بالخلافة من غيره ـ ولا يناسب المقام التعرّض لتلك الروايات في هذا المبحث ـ والغرض أنّ مبايعة الناس للإمام علي× لا تعني عودة النظرية الصحيحة في الحكم، وإنْ أسهمت في عودة شخص الحاكم الذي أراده الله سبحانه وتعالى.
حاول الإمام× أنْ يقوم بإصلاح الأُمور التي أفسدها مَن كان قبله، لكنّه قُوبل بانشقاقات وحروب فتّتت جيشه، وانهكت قواه.
فمعاوية الذي تربّع على خلافة الشام، بعد أنْ ولّاه عمر عليها، ثمّ ولّاه عثمان[318]، رفض الخضوع لخلافة عليّ×، وأعلن المعارضة بحجّة المطالبة بدم عثمان، فدخلت الأُمّة في منعطفٍ خطير آخر، حيث بدأ الصف يتصدّع، وباتت الشام خارجة عن حكم الإمام×.
وقد أسفرت فترة حكم الإمام× عن ثلاث حروب، ابتدأت بحرب الجمل، بقيادة عائشة ومعها طلحة والزبير الذين نكثوا البيعة، ومروراً بحرب صفّين مع معاوية واتباعه، وانتهاءً بحرب الخوارج (النهروان).
وبعد مقتل عليّ ×، توجهت الناس إلى الإمام الحسن× وبايعته بالخلافة، ثمّ صار ما صار من أمر الصلح، وانتقلت الخلافة إلى الشام، وأخذ معاوية يعيث بالأرض فساداً، خصوصاً أنّه نقض شروط الصلح، وصرّح بأنّ قتاله لأهل العراق لم يكن من أجل الصلاة أو الصوم، بل كان من أجل أنْ يتأمّر عليهم.
وقد سبق أنْ تحدّثنا قليلاً عن حياة معاوية، وعدم شرعيّة خلافته، وارتكابه المحرّمات، وقتله للخلّص من الصحابة، واتّباعه أساليب الترهيب والتجويع ضد كلّ من يختلف مع سياسته، أو يكون موالياً لعلي×، بل وذكرنا ما يدلّ على خروجه عن ملّة الإسلام.
ثمّ إنّه أحدث بدعة جديدة في المجتمع الإسلامي، وهي بدعة التوريث، حين أخذ البيعة بولاية العهد لولده يزيد، وهو منعطفٌ خطير آخر في مسار الأُمّة.
فالأُمّة مرّت بعدّة منعطفات خطيرة، أفقدتها هويتها الإسلامية، وهذه المنعطفات هي:
1ـ ما جرى في السقيفة من تنصيبٍ لأبي بكر، وإقصاء البيت العلوي عن الخلافة.
2ـ ما تلاها من انحرافات في عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، خصوصاً في زمن خلافة عثمان، وتحديداً في النصف الثاني من خلافته.
3ـ الانشقاق الكبير الذي حصل في خلافة عليّ×، بعد أنْ نكث طلحة والزبير بيعتهما، وخرجا مع عائشة، وكذلك استئثار معاوية بالشام، ورفضه طاعة الخليفة، وما تلاه من حرب صفين.
4ـ ما جرى في خلافة الحسن× من ظروف ألجأته إلى الصلح مع معاوية ضمن شروطٍ معيّنة، وبالتالي تسنّم معاوية شؤون الخلافة على كافّة الأُمّة الإسلامية.
5ـ أخْذ معاوية البيعة بولاية العهد ليزيد بطرقٍ ملتوية، وتحويل مسار الخلافة إلى التوريث.
هذه أبرز المنعطفات التي مرّت بها الأُمّة الإسلامية، والتي تحوّل بعدها المجتمع الإسلامي إلى مجتمع هزيل فاقد للإرادة، ميّت الضمير، يعرف الحقّ ولا يقوى على نصرته، فترهيب معاوية وترغيبه، وعمله على تفكيك المجتمع أوصل الأُمّة الإسلامية إلى هوّةٍ سحيقة، لا تكاد تُسمع معها كلمة الحقّ، إلّا من قلائل يكون مصيرهم القتل أو التشريد، وإلّا فالغالب رضيَ بتلك العيشة الذليلة، إزاء حفنة إغراءات زائلة، أو إزاء تهديد بسيط. فروح الأُمّة سُلبت، وناموا في سباتٍ عميق، لا يقوَون على النُّطق بكلمة الحقّ، مع معرفتهم به وتشخيصهم له، وهذا ما صوّره الفرزدق حينما التقى بالإمام الحسين×، وسأله عن القوم، فقال: «قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أُميّة[319].
فالناس بقلوبها مع الحسين لمعرفتها بالحقّ، لكنّها خاضعةٌ وذليلة، وأدوات بيد بني أُميّة، وهذا التحوّل الكبير في المجتمع الإسلامي كان يحتاج إلى تحرّك وموقف صريح يوقظ ضمير الأُمّة، ويُعيد إليها روحها الرسالية، خصوصاً بعد ما تولّى يزيد ـ مع انحرافه وتهتّكه ـ خلافة الأُمّة الإسلامية، ممَّا يعني أنّ الأُمّة سائرة باتجاه محو الرسالة، والقضاء على ما تبقّى منها، فأطلق الحسين× صرخته المباركة، وصرّح بهدفه من الخروج، وهو طلب الإصلاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ما نلمسه بوضوح من خلال رسائله أو خطاباته التي ذكرها المؤرِّخون، مع أنّه بغضّ النظر عن وجود كلمات وأقوال تبيّن هذا الهدف من عدمه، فإنّ نفس رفض الحسين× لبيعة يزيد، وتحرّكه في ضوء ما آلت إليه أوضاع المجتمع الإسلامي من انحدارٍ مخيف صوب الهاوية، كان ضمن هذا الإطار، لكن ومن باب الاستئناس والتأييد، لا بأس من الوقوف على بعض كلمات الإمام الحسين× المبيّنة لهدفه هذا[320]:
أوّلاً: لعلّ أوّل ما نقف عليه في هذا الباب هو الوصيّة التي كتبها الإمام الحسين× إلى أخيه محمّد بن الحنفية، يوضّح فيها الهدف الرئيس من ثورته، وقد جاء فيها: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أُمّة جدّي محمّد’، أُريد أنْ آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر[321].
وهذا الخبر صريحٌ بيّن في توضيح الهدف والمراد من خروجه×، وهو طلب الصلاح في هذه الأُمّة، وطلب الصلاح إنّما يتحقّق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس هناك هدفان أحدهما الإصلاح والآخر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو هدف واحد، وهو دعوة الأُمّة من خلال هرم السلطة فيها إلى الالتزام بالتكاليف الآلهية، من الأتيان بالواجبات والانتهاء عن المحرّمات، فإنّه إذا تحقّق ذلك تحقّق الصلاح في المجتمع الإسلامي.
ثانياً: إنّ الحسين خطب جماعته وجماعة الحُرّ في الطريق خطبةً، جاء فيها: «أيّها الناس، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، قال: مَن رأى سلطاناً جائراً، مستحـلّاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنّة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، يعمل في عباد الله بالأثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قول؛ كان حقّاً على الله إنّ يدخله مدخله، ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر[322].
وهذا الخبر أيضاً يشير إلى هدف الإمام الحسين× بوضوح، فإنّ تحركه إنّما كان بهدف ردع السلطان الجائر، المستحلّ لحرم الله، والناكث لعهده، والمخالف لسنّته، فقد بدأ خطابه ببيان القضيّة العامّة، وهي وجوب التحرّك والوقوف بوجه السلطان المتجبّر، المنحرف عن جادّة الحق، المخالف للسنّة النبويّة، ثمّ بيّن أنّ الحاكم الفعلي إنّما هو مصداق لذلك الحاكم المنحرف، فبيّن أنّ يزيد ومَن معه قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله.
إذاً؛ فيزيد وزبانيته منحرفون عن الشـريعة، ووجب الوقوف بوجههم، والحسين× أحقّ من غيره بذاك؛ لقرابته من رسول الله كما صرّح بذلك على ما في بعض المصادر[323]، فتحرّكه كان ضمن إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثالثاً: ورد أنّ الحسين× حين رأى نزول عمر بن سعد وجيشه إلى ساحة المعركة، وأيقن أنّهم قاتليه، قام خطيباً في أصحابه، فقال: «قد نزل ما ترون من الأمر، وإنّ الدنيا تغيّرت وتنكّرت وأدبر معروفها، واستمرّت حتّى لم يبقَ منها إلّا كصبابة الإناء، وخسيس عيشٍ كالمرعى الوبيل، ألا ترون الحقّ لا يُعمل به، والباطل لا يُتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برماً[324].
وهذا الخبر كسابقيه صريحٌ في تحديد الهدف، فالإمام يصوّر ما حلّ بالأُمّة من انحراف، حتّى لم يبقَ فيها من المعروف سوى اليسير، وأنّ الحقّ لا يُعمل به والباطل لا يُتناهى عنه، فتحرّك الإمام كان بصدد الأمر نحو الحقّ، والنهي عن الباطل، فهو يتحدّث عن نفس الإطار المتقدّم، إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
رابعاً: إنّ الإمام الحسين× كتب كتاباً إلى وجهاء وأشراف أهل البصـرة، جاء فيه: «أمّا بعد، فإنّ الله اصطفى محمّداً (صلّى الله عليه وسلّم) على خلقه، وأكرمه بنبوّته، واختاره لرسالته، ثمّ قبضه الله إليه، وقد نصح لعباده، وبلّغ ما أُرسل به (صلّى الله عليه وسلّم)، وكنّا أهله وأولياءه، وأوصياءه وورثته، وأحقّ الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك فرضينا، وكرهنا الفرقة وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنّا أحقّ بذلك الحقّ المستحقّ علينا ممَّن تولّاه ... وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه (صلّى الله عليه وسلّم)، فإنّ السنة قد أُميتت، وإنّ البدعة قد أُحييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدِكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله[325].
وهذا الكتاب يحتوي على مضامين مهمّة جدّاً، فهو يوضح لأهل البصـرة أنّ الخلافة تكون لأهل البيت^ بعد النبيّ’، وأنّهم أحقّ الناس بها، لكنّهم سكتوا عن ذلك مراعاة لجمع الكلمة وعدم الفرقة، لكنّ الأمر وصل إلى الهاوية، وأنّ سنّة النبيّ’ وشرعته التي جاء بها قد أُميتت وغُيّبت، ولم يبقَ منها سوى الاسم، وأنّ البدعة قد أُحييت، فكان لا بدّ من التحرك لإحقاق الحق وإحياء السنّة، وإزهاق الباطل وإماتة البدع والأباطيل التي راجت في المجتمع الإسلامي، فرسالته صريحة في إرادته القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
شبهة عدم تحقّق شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجواب عنها
هذا، وقد يُقال: إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شرائط معيّنة، لا بدّ من تحقّقها لاكتساب العمل مشـروعيته الدينية، أيّ أنّ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بدّ أنْ يتحرك وفق شروط معيّنة، إنْ تحقّقت اكتسب تحرّكه الشرعية، وإلاّ فلا، منها: احتمال التأثير. ومنها: عدم الضرر.
1ـ عدم تحقّق شرطيّة احتمال التأثير
فقد يُقال إنّ هذا الشرط غير متحقّق في ثورة الإمام الحسين×، فإنّ احتمال التأثير ميؤوس منه في وقت خلافة يزيد بن معاوية؛ لأنّ يزيد وصل إلى مراحل متمادية في الانحراف، ومستعدّ للقيام بكلّ شيء من أجل بقائه في السلطة، فلا يُتوخّى منه ولا يتوقع منه أنْ يتغيّر، ولذا فإنّه في أوّل تسنّمه السلطة كان كلّ تفكيره منصبّاً في كيفية أخذ البيعة من الإمام الحسين× وابن الزبير، ولو كان ذلك بقوّة السيف[326].
2ـ عدم تحقّق شرطية عدم الضرر على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر
ويمكن القول أيضاً أنّ هذا الشـرط غير متحقّق أيضاً؛ إذ لا يخفى على الحسين× في أنّ الإقدام على هكذا عمل سوف يُوجب الضـرر عليه وعلى عائلته وأصحابه، خصوصاً أنّ الشرط هو احتمال الضرر وليس اليقين بالضرر، واحتمال الضرر متحقّق حتماً، فإنّ كلّ الظروف التي اكتنفت تلك الفترة تُوحي بإنّ رفض الحسين× للبيعة وتحرّكه نحو العراق إنّما هو محفوف بالمخاطر، ولذا فإنّ جملة من الصحابة كانوا متخوّفين جدّاً من خروج الإمام الحسين×، وكانوا يطلبون منه عدم الرحيل، فمثلاً لقيه عبد الله بن مطيع، فقال له: «جعلت فداك، أين تريد؟ قال: أمّا الآن فإني أريد مكّة، وأمّا بعدها فإنّي أستخير الله، قال: خار الله لك، وجعلنا فداك، فإذا أنت أتيت مكّة فإياك أن تقرب الكوفة، فإنّها بلدة مشؤومة، بها قُتل أبوك، وخُذل أخوك، واُغتيل بطعنةٍ كادت تأتى على نفسه، الزم الحرم، فإنّك سيّد العرب، لا يعدل بك والله أهل الحجاز أحداً، ويتداعى إليك الناس من كلّ جانب، لا تفارق الحرم، فذاك [327] عمّى وخالي، فوالله، لئن هلكت لنسترقنّ بعدك[328]. فمن الواضح أنّ عبد الله بن مطيع كان متخوّفاً من أنّ رحيل الإمام الحسين× إلى العراق سيؤدّي إلى قتله.
وممَّن عارض رحيله عبد الله بن عمر، فلمّا سمع بخروجه، قدّم راحلته، وخرج خلفه مسرعاً، فأدركه في بعض المنازل، فقال: «أين تريد يا بن رسول الله؟ قال: العراق. قال: مهلاً، ارجع إلى حرم جدّك. فأبى الحسين× عليه، فلمّا رأى ابن عمر إباءه، قال: يا أبا عبد الله، اكشف لي عن الموضع الذي كان رسول الله’ يقبّله منك. فكشف الحسين× عن سرّته، فقبلها ابن عمر ثلاثاً وبكى، وقال: أستودعك الله، يا أبا عبد الله، فإنّك مقتول في وجهك هذا[329].
وممَّن عارض خروجه وخشي عليه القتل المسور بن مخرمة، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وعبد الله ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله الانصاري، وغيرهم[330].
كما أنّ المتتبّع لكلمات الإمام الحسين× من حين خروجه ولغاية وصوله لكربلاء، ليتّضح له جليّاً أنّ الإمام الحسين× عالم بالخطر الذي يداهمه، بل قد أخبر عن شهادته في أكثر من موضع.
والخلاصة: إنّ الحسين× كان عالماً بأنّ خروجه تحفّه المخاطر، ومعه ينتفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الجواب على عدم تحقق شرطية احتمال التاثير
وقد أُجيب عن الشرط الأوّل وهو احتمال التأثير، بأنّه متحقّق في الثورة الحسينية؛ لأنّ احتمال التأثير له أنواع، فتارة يلحظ التأثير الآني الفوري، وتارة يلحظ التأثير ولو بعد فترة زمانية، كما أنّه تارة يُلحظ التأثير في خصوص من أُمر بالمعروف أو نُهي عن المنكر، وتارة يُلحظ التأثير في بقية أفراد المجتمع، وإنْ لم يتأثّر الشخص المباشر.
فإنْ قيل إنّ شرط التأثير إنّما هو التأثير الفوري المباشر بعد الفعل، كما أنّ المتأثّر لا بد أنْ يكون نفس المأمور، فهنا يمكن القول إنّ هذا الشـرط غير متحقّق في الثورة الحسينية؛ لأنّ التأثير الآني لم يتحقّق، كما أنّ شخص المأمور لم يتأثّر.
لكنّ هذا غير صحيح، فإنّ التأثير المطلوب ليس هو الآني، بل يكفي حصول التأثير ولو بعد فترة زمنية، كما أنّ التأثير لا يشترط أنْ يحصل لنفس الشخص، بل يكفي حصول التأثير لبقية الأفراد، ومن الواضح أنّ الثورة الحسينية أحدثت هزّة في الأُمّة، وأيقضتها من سباتها، وفضحت زيف وأكاذيب بني أُميّة، وبيّنت انحراف حكمهم، وابتعاده عن جادّة الشـريعة، وعدم تمثيله للخلافة الإلهية، كما أنّ ثورة الحسين× حرّكت الإرادة في نفوس المجتمع، وألهبتهم روح الثورة والتضحية، والقدرة على الوقوف بوجه الظالمين، ممّا أدّى إلى حصول ثورات، هدفها القضاء على يزيد وحكمه المتجبّر.
كما أنّه يمكن القول إنّ الشق الثاني وهو مسألة اشتراط التأثير في نفس المأمور من عدمه، لا نحتاج فيه إلى القول بإنّ التأثير لغير المأمور يكفي، فإنّ تأثير ثورة الحسين× كان متحقّقاً في نفس المأمور أيضاً؛ لأنّ الثورة الحسينية وإنْ كانت متوجّهة ضدّ يزيد إلّا أنّ هدفها كان إيقاظ شعور الأُمّة، وإعادتها إلى جادّتها الصحيحة؛ بسبب سياسات الحكام الجائرة، فثورة الحسين× ودعوته الإصلاحية وإنْ كانت منصبّة باتجاه الحاكم الظالم، إلّا أنّها شاملة لكلّ الأُمّة، فالحسين× أراد من أبناء الأُمّة أن يعودوا إلى رشدهم، ويتمسّكوا برسالتهم، وأنْ يعيشوا أحراراً رافضين لكلّ أنواع الظلم، كما أراد الله لهم ذلك، فثورة الحسين× ثورة إصلاحية على كافّة الأصعدة، فمن جهة يريد تعرية بني أُميّة وإسقاط حكمهم وكشف زيفهم أمام الناس، ومن جهة يريد تحريك إرادة الناس، وإعادة الروح الدينية في نفوسهم، وعتق رقابهم من العبودية الأُموية. فالأُمّة إذاً كانت منظورة في الخطاب الحسيني والحركة الحسينية، ولم يكن يزيد وجهازه الحاكم هو محور التحرّك فقط، بل يمكن لقائلٍ أنْ يقول: إنّ الأُمّة لو كانت تمتلك الإرادة، وثابتة على أهدافها الرسالية لما كانت هناك حاجة للثورة الحسينية، فلم تكن ثورة الحسين× وليدة الحكم الجائر فقط، بل هي وليدة خليط من حكم جائر وأُمّة تخلّت عن قيمها ومبادئها؛ نتيجة سلسلة من نماذج ذلك الحكم، فالثورة إذاً كانت متجّهة للأُمّة أيضاً، وقد أتت أُكلها، فقد استطاع الحسين× بثورته أنْ يعيد مسار الأُمّة، ويعيد إليها كرامتها، ويحرّرها من ذلّ العبودبة، لتنطلق الثورات بعد ذلك مؤذنة بانتصار الحسين× وقيمه ومبادئه التي نادى بها.
وقد يُقال: إنّ ما ذكرتموه من تأثيرٍ مستقبلي وقع على الأمّة إنّما يتمّ وفق نظرية النص والعصمة والعلم المستقبلي، وأمّا إذا قلنا بعدم ذلك وفق النظرية الأُخرى، فكيف يمكن معرفة التأثير المستقبلي؟
لكنّ هذا الكلام ضعيف جدّاً، فإنّ قراءة الأحداث ومعرفة نتائجها لا يتوقّف على العصمة والعلم الغيبي وغيرها، فأيّ قائد يمتلك من المواصفات والمؤهّلات مثلما يمتلكه الإمام الحسين× من العلم والمعرفة، والحنكة السياسية، يستطيع أنْ يقرأ الواقع الذي يعيش فيه، ويستشـرف النتائج والمعطيات التي ستحصل لاحقاً، فالحسين× باعتبار موقعه الاجتماعي، وأنّه ابن بنت رسول الله’، وابن عليّ بن أبي طالب×، وله ما له من الفضائل العديدة، التي يعرفها الصحابة والتابعون وأصحاب ذلك المجتمع، مضافاً لما يمتلكه من علم، وحنكة، وسياسة، وحسن تدبير، يمكّنه بسهوله أنْ يستشـرف المستقبل، وأنّ ثورته وإنْ لم تحقّق ثمارها بصورة آنية، إلّا أنّها ستؤثّر بالنفوس رويداً رويداً، وتخلّص المجتمع من آفة الجبن، وفقدان الإرادة، وتزرع فيه ثمار الإيمان مجدّداً؛ ليتمكّن مجدّداً من الدفاع عن رسالته، ومبادئه التي يؤمن بها.
الجواب على عدم تحقّق شرطية الأمن من الضرر
عرفنا ما يتعلّق باشتراط احتمال التأثير، وأمّا ما يتعلّق بالأمن من الضـرر، فهنا لا يمكن القول إنّ الحسين كان آمناً من الضرر؛ فقد عرفنا أنّ رحلته كانت محفوفة بالمخاطر، وأنّه× كان عارفاً بذلك، غير أنّه يمكن القول إنّ الخوف من الضرر الذي ذكروه إنّما كان متعلّقاً بما إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشخصي بمعنى لو أنّ هناك أحد أفراد المجتمع ارتكب معصيّة معيّنة، كما هو حاصل ويحصل في مجتمعاتنا، وهذه المعصية لا تعود بالضـرر إلّا عليه، فهنا يجب على الآخرين أنْ يأمروه بالمعروف وينهوه عن معصيته، لكن ضمن الشروط المذكورة، بما فيها احتمال التأثير فيه، أي أحتمال اقلاعه عن تلك المعصية، وأنْ لا يكون هناك ضرر شخصي يعود على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
أمّا لو كانت المعصية لا تعود بالضرر على الشخص العاصي فقط، بل تعود على الدين الإسلامي بأجمعه، بمعنى أنّ تلك المعصية أو المعاصي المرتكبة ستؤدّي إلى هدم الدين وضياعه، ومحو الرسالة السماوية، فمن الواضح هنا أنّ النفوس تكون رخيصة فداءً للدين والإسلام، فإنّ من أهم الواجبات على الفرد أنْ يحافظ على هذا الدين، وأنْ يسعى في تثبيت أركانه، بمعنى أنّ المفسدة المترتّبة على ضياع الدين هي أهمّ بكثير من المفسدة المترتبة من تعرّض الشخص للضرر، فكلّ إنسان مؤمن لو خُيّر بين أنْ يتعرّض للضرر بنفسه ويبقى الدين سليماً، أو أنْ يحافظ على نفسه ويضيع الدين وتُمحى الرسالة، لا شكّ أنّه سوف يختار الحفاظ على الدين، ويعرّض نفسه للضـرر؛ ولذا فإنّ المسلمين في عصـر النبيّ’ وبعده، كانوا يضحّون بأنفسهم في سوح الجهاد من أجل رفع راية الإسلام.
ولو لاحظنا الفترة التي عاشها الإمام الحسين×، خصوصاً بعد تولّي يزيد زمام أُمور المسلمين مع فسقه ومجونه، ومع ملاحظة تحوّل الخلافة إلى وراثة وملك لبني أُميّة، وتحوّل المجتمع الإسلامي إلى سلع رخيصة تتقاذفها الأهواء، وباتوا غير قادرين على النطق بكلمة الحقّ، لاتّضح جليّاً أنّ الخطر صار محدقاً بالإسلام من الأساس، والحسين× بمنزلته الرفيعة، ومكانته الكبيرة في المجتمع الإسلامي، كان أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا القبول ببيعة يزيد، وهذا يعني إضفاء الشرعية على حكم بني أُميّة المتمثّل بيزيد، وبالتالي ضياع الإسلام ومُثله وقيمه بمباركة حسينية، وهذا ما لا يمكن أنْ يتخذه الحسين×، وقد أشار إليه في بعض كلماته حين أمره مروان ببيعة يزيد، حيث أجابه قائلاً: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام؛ إذ قد بُليت الأُمّة براعٍ مثل يزيد[331].
فالحسين× كان يُدرك جيّداً أنْ لا بقاء للإسلام في ظلّ حكومة يزيد، فلم يكن له سوى الخيار الثاني، وهو رفض البيعة والتحرّك لفضح زيف الحكم الأُموي، وتوعية الأُمّة مهمّا ترتّب على ذلك من نتائج، فالرسول’ كابد الأمّرين، وأُوذي وحُوصر، وكلّ ذلك في سبيل تثبيت عُرى الإسلام، وجعل شجرة الإسلام باسقة متلألئة، تحمل ثمار الرسالة بقيمها ومبادئها السامية، وقد حانت الساعة التي أُريد لهذه الشجرة أنْ تُقلع، وأنْ يُغيّب صوت محمّد’، لتعود الجاهلية من جديد، فما عسى الحسين× أنْ يفعل، وهو امتداد لذلك الصوت الرسالي، وهو بضعة من تلك النفس الطاهرة، وهو هو الذي قال فيه صاحب الرسالة: «حسين منّي وأنا من حسين[332]. فكلاهما يحملان مشـروعاً واحداً، وهدفاً واحداً، فالرسول’ جاهد وقاتل وعانى ما عانى في سبيل نشر الرسالة، فما كان على الحسين× إلّا أنْ يُضحّي بنفسه من أجل بقاء تلك الرسالة، وقد فعل ذلك.
شبهة تناقض العلم بمقتله وإرساله مسلم بن عقيل إلى الكوفة
بقيَ هناك شيء، وهو أنّ الحسين× على ما تبنيّناه من معرفته وعلمه بمقتله[333]، فإنّه إذا كان يعلم بالخطر الذي يداهمه كما أسلفنا، وأنّ حياته مهدّدة بالقتل، لكنّه قتْلٌ في سبيل الحفاظ على الإسلام، وهو مشروع بلا كلام، لكن قد يرد إلى الذهن تساءل عن معنى إرساله مسلم بن عقيل إلى الكوفة، ليأخذ له البيعة، ولمَ لمْ يرجع حين علم باستشهاده وخيانة أهل الكوفة له.
وللجواب على ذلك نقول:
1ـ إنّ الحسين كان يعلم مسبقاً أنّ الأُمّة بحاجة إلى هزّة ضمير، وبحاجة إلى ثورة ولو كلّفته دمه ودم أبنائه وأنصاره وسبي نسائه، فإنّ المجتمع لا يمكن أنْ يصحو من غفوته دون أنْ تحدث تلك الصدمة.
والحسين× من أوّل تحركه كان يهدف إلى هذا الأمر، ولكن ذلك لا يمنع من أنْ يستجيب لحركة المجتمع، ويتفاعل معها طبق الظروف الطبيعية، فليس ثمّة تناقض بين تشخيص الإمام الحسين× لظروف تلك المرحلة، وبين الاستجابة لبيعة المجتمع له، فذلك لا يتعارض مع هدفه ومشـروعه، بل إنّ تلك الاستجابة تعطي حركته مشروعية أكثر، فمضافاً لما شخّصه الإمام× من انتشار للفساد في كلّ مفاصل الدولة والمجتمع الإسلامي، وأنّ عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ المجتمع بايعه ودعاه للمجيء، فإنّ إرسال مسلم بن عقيل إليهم يصبّ في نفس مشروع الإمام× من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحجة على المجتمع والسلطة في آنٍ واحد.
2ـ إنّ وصول خبر استشهاد مسلم إليه لم يكن ليغيّر من الواقع شيئاً، فإنّ إرسال مسلم إلى الكوفة يدخل في ضمن إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزيادة في إلقاء الحجّة على المجتمع والسلطة، فخبر استشهاده، ليس إلّا زيادة يقين بأنّ الوضع المتأزّم يحتاج إلى تضحيات، وإنّ الكلمة لوحدها لم يعد لها وقع، وليس لها آذان صاغية، فلا بدّ من فعل خارجي يحرّك ضمير الأُمّة ويهزّ كيانها، فكان لا بدّ من الاستمرار بالحركة.
أضف إلى ذلك فإنّ انصراف الحسين× في ذلك الوقت، بل حتّى قبله لا يغيّر من الواقع شيئاً؛ لأنّ مجرد عدم بيعته ليزيد وإعلانه رفض خلافته هو موجب لقتله من قِبل أولئك الطواغيت، فكيف بما بعد إرساله مسلم بن عقيل، وتحرّكه بالكوفة، وما انتهى إليه الأمر من مقتله مع هاني بن عروة! فالنتيجة هي القتل لا محالة، والحسين× حينئذٍ مخيّر بين أنْ يكون قتله موجباً لتحريك المجتمع، وأنْ يكون ذا تأثير ملموس يحفظ معه كيان الإسلام، وبين أنْ يكون قتله باغتيال بارد مسبوق بانسحاب من مواجهة طواغيت بني أُميّة، وباعتبار أنّ الحسين× قائد رسالي، كان لا بدّ له من الاستمرار بثورته، وإلقاء الحجج على القوم، ويلاقي مصيره المحتوم.
وهذا الأمر واضحٌ جليّ في خطابات وكلمات الإمام الحسين×، فحين قرّر الخروج من مكّة، قال لابن عباس: «لإنْ أُقتل بمكان كذا وكذا أحبّ إلى من أنْ يستحلّ بي حرم الله ورسوله[334]. قال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح[335].
وقال لابن الزبير: «والله، لأن أقتل خارجاً منها بشبر أحبّ إلىّ من أنْ أُقتل داخلاً منها بشبر، وأيم الله، لو كنت في جحر هامّةٍ من هذه الهوام لاستخرجوني حتّى يقضوا فيَّ حاجتهم، ووالله، ليعتدُنَّ عليَّ كما اعتدت اليهود في السبت[336].
وقال لابن عمر: «هيهات يا بن عمر! إنّ القوم لا يتركوني وإنْ أصابوني، وإنْ لم يصيبوني فلا يزالون حتّى أُبايع وأنا كاره، أو يقتلوني[337].
وقد كرّر الإخبار عن موته بعد مقتل مسلم بن عقيل أيضاً، حين لقيه شيخ من بني عكرمة، ونصحه بعدم الذهاب، فأجابه قائلاً: «والله، لا يدَعوني حتّى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلّط الله عليهم مَن يذلّهم حتى يكونوا أذلّ فرق الأُمم[338].
فهو عارف بإنّ القوم لا يتركوه، وأنّ مصيره الشهادة؛ ولذا بعث من مكّة بكتاب إلى بني هاشم حين أراد الخروج، جاء فيه: «أمّا بعد، فإنّ مَن لحق بي استُشهد، ومَن لم يلحق بي لم يُدرك الفتح، والسلام[339].
فإذا كان الحسين× قد شخّص هدف القوم وإرادتهم قتله أينما استطاعوا ذلك ولو في مكّة، فتكون المسألة بعد مقتل مسلم بن عقيل بمستوى من الوضوح.
الحريّة ورفض الظلم والاستعباد وفق القانون الوضعي
من الأُمور الجليّة الواضحة في الثورة الحسينية أنّها ثورة تحرّر ضد قيود الظلم والاستعباد، فهي ثورة رافضة للظلم والتجبّر بأيّ شكل من أشكاله. وهذا الهدف وهو رفض الظلم والتجبّر يتّفق مع الفطرة الإنسانية، فإنّ الله خلق الناس أحراراً غير تابعين لجهة، ولا مكبّلين بقيود تذلّهم وتسلب كرامتهم، وهذا ما يشير إليه القول المعروف لعلّي بن أبي طالب×: «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً[340]. فالحريّة هي الأساس الذي خلق الإنسان عليه، لكن ذلك لا يمنع من تشريع قوانين، وسنّ أنظمة تمكّن الأفراد والمجتمعات من التعايش فيما بينها؛ إذ بدون قوانين ستتحوّل المجتمعات إلى غابات يفترس فيها القوي الضعيف.
فالحريّة المطلوبة إذاً هي تلك التي تتّفق مع القوانين المسنونة، ولا تتعارض معها، وهذه الحريّة كما كفلها الله سبحانه وتعالى لخلقه، وحيث إنّها أمرٌ فطري، فإنّ القوانين الوضعية أقرّتها أيضاً، ورفضت جميع أنواع الظلم الذي يتعرّض له الإنسان، سواء من الحكّام أم من غيرهم.
ومن أولويات الحريّة التي أعطتها القوانين الوضعية للإنسان هي حقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وأنّ الشعب هو مصدر السلطات، وهو مصدر التشريع، وأنّه لا يمكن للحاكم أو غيره أنْ يفرض على الشعب أيَّ شكل من أشكال الدولة، ولا أنْ يطبّق عليه القوانين بالقهر والإجبار، بل أعطى للشعب الحريّة في أنْ يختار نوع الحكم الذي يشاء، وأنْ يختار دستوره بنفسه وفق آليات قد تختلف من بلد إلى بلد، فقد يكون عن طريق الاقتراع المباشر لأنظمة دستورية معيّنة، أو الاقتراع لاختيار برلمان يوعز إليه كتابة دستور معيّن، وهكذا، والغرض أنّ اختيار نظام الحكم وشكل الدولة ودستورها إنّما هو بيد الشعب.
وهذا الأمر تقرّ به حتى الدول الجائرة الاستبدادية؛ إذ لا تجد دولة تدّعي أنّها استبدادية، بل تعلن من حيث النظرية والقانون أنّها حكومة ناشئة من الشعب.
ثمّ إنّ القوانين الوضعية ركّزت على احترام حريّة الفرد والمواطن، وحافظت على حقوقه في فقرات عدّة، فرفضت التمييز العنصـري، ورفضت الاضطهاد بشكل عام، وكذلك الاضطهاد الناشئ من اختلاف فكري، أو عقدي، أو ثقافي، بل أعطت للمواطن حريّة اختيار عقيدته وديانته من دون أيّ إجبار في ذلك.
وهذه الأُمور واضحة بيّنة، تنصّ عليها الكثير من الدساتير العالمية، ونحن هنا نقتصر على ذكر بعض من فقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المادة (1): «يُولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وُهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة (2): «لكلّ إنسان حقّ التمتّع بكافّة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أيّ تمييز، كالتمييز بسبب العنصـر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو أيّ رأيٍ آخر، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو أيّ وضع آخر، دون أيّة تفرقة بين الرجال والنساء.
وفضلاً عمّا تقدّم فلن يكون هناك أيّ تمييز أساسه الوضع السياسي، أو القانوني، أو الدولي لبلد، أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاًّ، أو تحت الوصاية، أو غير متمتّع بالحكم الذاتي، أو كانت سيادته خاضعة لأيّ قيدٍ من القيود.
المادة (3): «لكلّ فرد الحقّ في الحياة والحريّة وسلامة شخصه.
المادة (5): «لا يُعرَّض أيّ إنسان للتعذيب، ولا للعقوبات، أو المعاملات القاسية، أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة (18): «لكلّ شخص الحقّ في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحقّ حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة، وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرّاً أم مع الجماعة.
المادة (19): «لكلّ شخص الحقّ في حريّة الرأيّ والتعبير، ويشمل هذا الحقّ حرية اعتناق الآراء دون أيّ تدخّل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقّيها وإذاعتها بأيّة وسيلة كانت، دون تقيّد بالحدود الجغرافية.
المادة (21): «(1) لكلّ فرد الحقّ في الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة لبلاده، إمّا مباشرة، وإمّا بواسطة ممثّلين يُختارون اختياراً حرّاً.
(2) لكلّ شخص نفس الحقّ الذي لغيره في تقلّد الوظائف العامّة في البلاد.
(3) إنّ إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية، تجري على أساس الاقتراع السرّي، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أيّ إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
وكذلك فإنّ هذه القوانين لم يفُتْها أنْ تشير إلى ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، وإنصاف المظلوم من الظالم وغيرها ممّا يُقنِّن حرية الإنسان، وحفظ كرامته على كافّة الأصعدة.
وحينما أشرنا إلى أنّ الشعب هو مصدر التشريع، وقلنا إنّ الحريّة حقّ طبيعي لكلّ فرد ومجتمع، لا نعني أنّ الدول التي تقوم على نظام الانتخابات هي دولة عادلة، حقّقت لمواطنيها العيش الكريم، ودافعت عن حرياتهم، وضمنت لهم كافّة أنواع الحقوق، بل أردنا أنْ نشير إلى أنّ القوانين من الجهة النظرية تتبنّى مبدأ حرية الفرد والمجتمع، وتدعو إلى تطبيق العدالة الاجتماعية، ونبذ التفرقة والظلم، وإنصاف المظلوم من ظالمه.
والواقع أنّ هذه القوانين ـ بما تحويه من مفاهيم وقيم أخلاقية ـ لم تكن موضعاً للتطبيق في كثير من الدول، سواء تلك السابقة لوضع هذه القوانين أم اللاحقة لها؛ وسواء كانت تلك الدولة تؤمن بالنظم الديموقراطية أو غيرها من الدول الاستبدادية؛ لذا فالإنسان يعيش في دولة تُقرُّ قوانينُها الحريّات، لكنّه يعيش مُستعبداً ذليلاً، منهوب الثروات، فاقداً للكرامة، فكم من دولةٍ تُقصـي أبناءها لمجرّد انتماءٍ مذهبي، أو حركةٍ فكرية، أو لكونه ذا لونٍ معيّن.
بل أحياناً يتعدّى الموضوع عدم تطبيق القوانين إلى وضع الدولة لقوانين جائرة تقوم بفرضها على الناس، بل لربّما يكون القانون في فترة قانوناً عادلاً، ينسجم مع مصالح المجتمع وتطلعاته، وفي فترةٍ أُخرى يكون قانوناً ظالماً، ونتيجةً لذلك يقع التنازع بين قوّة الدولة التي سنّت قوانين ظالمة، أو لم تطبّق القوانين المسنونة، وحكمت الشعب بالتجبّر والغَلَبة، وسلب الحريّات، وبين قوة العقل البشري، والفطرة الإنسانية الداعيين إلى تطبيق العدالة، وبين هاتين القوَّتين تتوزع آراءُ الفلاسفة والكُتّاب والفقهاء وتتراوح، فمنهم مَن يغلِّب قوة العدل على قوّة السلطان، فيُبيح تحدّي قوى الدولة فيما تفرضه من قوانين ظالمة، ويتدرّج ذلك من مجرَّد العصيان إلى الثورة، وهذا ما أخذت به الثورة الفرنسية فيما أعلنتْه من حقوق الإنسان؛ إذ اعتبر أحد الدساتير التي تمخّضت عنها أنّ الثورة على الظلم ومقاومته هو من ضمن هذه الحقوق[341].
فالثورة إذن تعدُّ أحد حقوق الإنسان، فيما إذا تعرّض إلى الظلم والاضطهاد، وصُودرت حريّاته؛ لأنّ شرعية الحكومة تسقط حين تتخلّى عن تطبيق القوانين بصورة صحيحة، ولأنّ هناك علاقة بين الحاكم والمحكوم، مكّنت الحاكم من ممارسة صلاحيته وفق شروط معيّنة، و«يذهب الرأي الغالب لدى الفلاسفة والمفكّرين السياسيّين في تكييف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، إلى تصوّر وجود عَقْد بين الطرفين، نشأ عندما اتّفق الناس، في وقتٍ ما، سعيًا وراء السعادة والسلام والعدل، على الخروج من حالة الطبيعة، إلى الحياة في جماعة سياسية، فأبرموا عقدًا اتّفقوا فيه على خَلْقِ سلطة تعلو إرادتهم، نازلين لها عن شطرٍ من سلطاتهم الطبيعية وحقوقهم القديمة، نظير أن يُصان ما كانوا محتفظين به من هذه الحقوق.
أما إذا تنكَّر الأُمراء للشعوب، وطرأ ما يُبطِل العقد أو يخلُّ بشروطه، فإنّه يتمخّض عن ذلك واجبُ الثورة على الأمير؛ لأنّ الشعب لم يفوِّضه السيادة تفويضًا مطلقًا، بل تفويض كان مقروناً بشرطٍ فاسخ... فمنذ القرن السادس عشر شرح جون لوك نظريته عمَّا أسماه: (مبدأ الحقِّ الخفي للثورات)، حيث سلَّم بالحق في الثورة ضدّ السلطة التنفيذية، وضدّ السلطة التشـريعية بسبب مساوئ الحكم والتشـريع، وقد دافع عن حقِّ الشعب في العصيان.
وقد أدّت هذه النظريات التي تبنَّاها فلاسفة القرن الثامن عشـر في أوروبا إلى اندلاع الثورة الفرنسية على الملكية بسبب مساوئ الحكم، وكان أول عمل للجمعية التأسيسية وضعُ (إعلان حقوق الإنسان والمواطن) وإقراره، وقد تضمَّن نصّاً واضحاً بحقِّ مقاومة الاضطهاد (مادة 2)، ولكنّ هذه النصوص لم تَرِدْ في كلِّ الدساتير التالية، وإنّما وَرَدَتْ في دستور العام 1793م، الذي نصَّ على أنّ الحكومة عندما تعتدي على حقوق الشعب، فالثورة لكلِّ الشعب (أو لفئة منه) هي أقدس الحقوق وألزم الواجبات، وقبل ذلك وَرَدَ في (وثيقة الاستقلال)، التي وضعها الثائرون الأمريكان في العام 1776م: إنّ الحكومة إذا هي عطَّلتْ حقوق الإنسان في المساواة والحرية وانتفاء السعادة، يمكن للشعب أن يثور عليها، ويقلبها ويضع مكانها هيئة تعيد نظام العدل والحرية، وقال أبراهام لنكولن في السنة 1861م: إنّ البلاد الأمريكية هي مُلك للشعب، وإذا ضاق هذا الشعب بأخطاء الحكومة القائمة، فله أن يستعمل حقَّه الدستوري في تعديلها، أو حقَّه الثوري في هدمها.
وقد استقرّ الاعتراف بحقِّ المقاومة في فقه القانون العام، فيقول العميد هوريو: إنّ حقَّ المقاومة ليس إلّا استدعاءً لحقٍّ قديم في الحرية، يعود ليؤكّد حقَّ المواطنين في الدفاع الشرعي ضد سوء استخدام السلطة.
ويقول العميد جني: إنّ حقَّ المقاومة هو الضمان الأعلى للعدالة وسيادة القانون.
ويقول لوفور: إنّ المقاومة هي ممارسة لحقِّ مراقبة السلطة المُعترَف به من المحكومين. ويذهب الفقيه الألماني إهرنغ إلى حدِّ جعل المقاومة هي النظرية الأصلية للقانون كلِّه، فيقول: إنّ القانون ليس هو المبدأ الأسمى الذي يحكم العالم؛ إنّه ليس غاية في ذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غاية.
إنّ الحياة فوق القانون، وعندما يصبح المجتمع في موقف الخيار بين احترام القانون والحفاظ على الوجود، فلا محلَّ للتردد، وعلى القوة أنّ تضحِّي بالقانون لتنقذ الأُمّة.
ويذهب العميد دوغيه في كتابه: (أُصول القانون الدستوري) إلى أنّ حقّ الثورة ما هو إلّا نتيجة منطقية لخضوع الحكّام للقانون.
وإنّ كلَّ إجراء يتَّخذه الحكّام مخالفٍ للقانون يخوِّل المحكومين سلطة قَلْبِ الحكومة بالإكراه؛ وهم إذ يحاولون ذلك، يهدفون إلى إعادة سيادة القانون...[342].
فالثورة إذاً على الظلم والتجبّر والاستبداد هي حقٌّ مشـروع للشعوب، كفلته القوانين الدولية، وصرّح به فقهاء القانون، وأوضحوا أنّ حقّ الثورة يستند إلى حقّ الدفاع المشروع، الذيّ يعدّ أهمّ موانع العقاب، يقول الدكتور عبد الله السلمو[343]: «أمّا إذا دخلنا إلى عالم الفقه والتشريع الدولي، لنرى المستند القانوني الذي يرتكز عليه حقّ الثورة: فيرى فقهاء الحقوق الجزائية أنّ حقّ الثورة يستند إلى حقّ الدفاع المشـروع، الذي أجمعت التشريعات الجزائية على أنّه أحد أهمّ موانع العقاب، سواء كان في المجال الفردي، أوفي المجال الجماعي، أي: الثورة لدرء العدوان على الوطن والمجتمع، وإلى هذا ذهب الفقيه الفرنسي (سوميير) بقوله: إنّ حقّ المقاومة يعتمد على حقّ الدفاع المشروع. (مبادئ القانون الأساسية: ص125).
كما قال الفقيه (هوريو): إنّ حقّ الثورة أو الانتفاضة ما هو إلّا امتداد لحقّ الحرية الذي يخوّل المواطنين حقّ الدفاع المشروع، وإلى هذا ذهب أُستاذ القانون الدولي محمّد طه بدوي بقوله في كتابه (حقّ مقاومة الحكومات الجائرة): يكفي لاعتبار النظام جائراً أن تجزع الجماعة ـ أي الشعب ـ من المبادئ التي يقوم عليها النظام، والممارسة ضدّ حريات الناس، وعدم معرفة مصيرهم على يد عصبة لم ينتخبها...
كما أكد الفيلسوف البريطاني لوك، صاحب نظرية حقّ الثورة ما يلي: إنّ الشعب في حالة خيانة حكّامه ـ للأمانة التي عهد بها إليهم، سواء كانوا مشـرّعين أو منفّذين ـ يملك حقّ الثورة عليهم... إنّني أحبّ السلم، ولكن لا أُريد سلماً بأيّ ثمن، سلماً يفرضه الأقوياء على الضعفاء، يفرضه الغاصبون على الشعوب، سلماً يكون كالسلم المزعوم بين الذئاب والخراف. (لوك، محاولة في الحكومة المدنية: ص135).
وحقّ الثورة هو مجرّد حقّ تقرير المصير، ويُعتبر هذا المبدأ من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وذلك تماشياً مع ميثاق الأُمم المتحدة، واضعاً البداية الأُولى والمهمّة في نشأة القانون الدولي المعاصر، والنظام العالمي بشكلٍ عام[344].
فالثورة ضدّ الظلم والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان تكتسب الشـرعية القانونية، بل إنّ الثوار يُعتبَرون موضع تقدير واحترام؛ لما قاموا به في سبيل فكّ قيود العبودية التي فرضتها السلطات الجائرة، ومَن يُقتل في ذاك الطريق تخلّده الشعوب، ويبقى رمزاً تتفاخر به الأُمّة، وتجعل من شخصه ـ خصوصاً إذا كان قيادياً معروفاً ـ قدوة وأنموذج تحتذي به، وتحثّ الناس على السير إثر خطاه، وتثير وتهيّج الرأي العام في الاستقاء من طريقته، وتشحذ الهمم عن طريق التغنّي بذكره.
ومن أوضح مصاديق مشروعية الثورات ضدّ الظلم والتجبّر هو ما اكتسبته الثورات ـ التي انطلقت في شتى أصقاع العالم، رافضةً للذلّ والخنوع ـ من تفاعل إنساني منقطع النظير، ومن اعتراف جماهيري ورسمي بها.
غير أنّه من الطبيعي أنّ التغيير إذا أمكن أنْ يكون بالطرق السلمية، ومن دون قتلٍ وقتال، فإنّ القوانين حينئذٍ ترفض الثورة، وتدعو الشعوب إلى التظاهر السلمي، ما دام يكفل تحرر الإنسان من ذلّ الاستعباد، ويحقّق له أهدافه من الحريّة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإسقاط عرش الطاغوت.
ونحن إذا ما رجعنا إلى الظروف التي اكتنفت ثورة الإمام الحسين×، لوجدناها جامعة للشرائط القانونية، فضلاً عن الشرائط الشرعية التي ذكرنا أكثرها فيما مضى.
فالخليفة في زمن الحسين× لم يُنتخب بصورة دستورية صحيحة، بل ساهمت السلطة الحاكمة آنذاك بكلّ ما أُوتيت من قوة، واستخدمت الترهيب والترغيب، وإغراء الناس بالأموال في سبيل تحصيل البيعة له، ومع ذلك لم تحصل له البيعة من الجميع، بل عارضها جملة من أهل الحلّ والعقد، وعلى رأسهم الإمام الحسين×.
ثمّ إنّ الخليفة كان يهدف إلى إقصاء دستور المسلمين، وتبديله بأحكام ظالمة جائرة، فكان الحقّ لا يُعمل به، والباطل لا يُتناهى عنه، بل إنّ الخليفة بنفسه كان متجاهراً بمخالفة الدستور، تاركاً للصلاة، شارباً للخمر، مستخفّاً بكلّ القيم والمبادئ.
أضف إلى ذلك أنّ الحريّات مُصادَرة، وأنّ القتل والترهيب مصير كلّ مخالف.
فالحكومة الأُموية بقيادة معاوية قمعت كلّ أنواع الحريّات، وقتلت عدّة من الصحابة والصالحين؛ لمجرد ولائهم لعلي بن أبي طالب×، وهو ما يُعبّر عنه اليوم بالقتل على الهويّة، ثمّ سلّطت فاجراً فاسقاً على رؤوس المسلمين، لا يملك ذرة من كياسة الحكم، ليسير على نفس أُسلوب القمع والإقصاء لكلّ مَن يخالفه بالرأي، فكان أوّل كتابٍ له، والهادف لتوطيد حكمه وسلطانه هو أخذ البيعة من الحسين× وغيره ممَّن لم يبايعوا بكلّ طريقة، ولو استلزم ذلك القتل.
ولم يكن الحسين× ليبدأ حركته بقتالٍ، بل ابتدأ ذلك بأُسلوب الرفض لبيعة هكذا حاكم، مبيّناً أنّ كلّ حرّ أبيّ لا يمكن أنْ يبايع مثل هذا المنحرف «ومثلي لا يبايع مثله[345].
وعدم البيعة هو حقٌّ طبيعي للإمام الحسين× كفلته الشـريعة والقوانين المداعية بحقوق وحريّة الإنسان، خصوصاً أنّ الخليفة لم يحصل على شرعية البيعة وفق أُطرها القانونية الصحيحة، لكنّ يزيد وأذنابه خشوا إنْ لم يبايع الحسين× سوف تُفتضح عدم شرعية حكمهم، فحاولوا أخذ البيعة بكلّ صورة ولو القتل، ولمّا أحسّ الحسين× بذلك ترك المدينة وغادر إلى مكّة، وكلّ همّه رفض إعطاء الشـرعية لهؤلاء الظلمة، مصـرّحاً بأنّ هدفه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وفي مكّة أيضاً كانت هناك محاولة لاغتياله×، ممّا أدّى به أنْ يتحرّك صوب العراق، مصرّاً على هدفه في نصرة الحقّ وكشف الباطل وتعريته.
والغرض أنّ الحسين× رغم ما يملكه من غطاء شرعي وقانوني لثورته، من قمعٍ للحريّات، وتكميمٍ للأفواه، وسلبٍ للإرادة، واغتصابٍ للخلافة، ودرسٍ للشريعة، إلّا أنّه ابتدأ ثورته برفض المبايعة، وبدأ يبيّن أهدافه من الثورة، وأنّها لإحقاق الحقّ وإبطال الباطل وإنصاف المظلوم، ولمّا رأى أنّ القوم لا تنفع معهم الكلمة، ولا يحرّك ضميرهم خطاب الحقّ، وأنّهم يسعون في قتله بشتّى الوسائل، استمر بصرخته المدوّية الرافضة لكلّ أنواع الظلم والتجبّر، حتّى سالت دماؤه الطاهرة في أرض كربلاء، ليوقض معها ضمير الأُمّة، وليبعث فيها روح التضحية والفداء من أجل القيم والمبادئ.
فالثورة الحسينية كونها ثورة نابعة من الضمير الحي، ومنطلقة من الفطرة الإنسانية، منادية بتحرير الإنسان والحفاظ على كرامته؛ استطاعت أنْ تفرض مشروعيتها وفق قوانين تأخّرت عنها مئات السنين.
فحين نحاول أنْ نؤطّر الثورة الحسينية بالأُطر القانونية؛ إنّما لنكتشف أنّها ثورة تتماشى مع كلّ أنواع التقنين، وأنّها ثورة تنبع من الفطرة السليمة، وأنّها محلّ اتفاق بين آراء العقلاء على مختلف توجّهاتهم وانتماءاتهم..
تناولنا في هذا الفصل ثلاثة مباحث رئيسية، اتّضح من خلال الأوّل فيها أنّه وفق نظرية النصّ فإنّ الإمام الحسين× يكون أحد المعصومين، وهو الخليفة الشرعي الذي يجب على الأُمّة طاعته، وأنّ يزيد لا يعدو كونه مغتصباً للخلافة، ويكون خروج الحسين× وتحرّكه هو الميزان الشرعي للأُمّة، فهو بحكم كونه معصوماً يكون عمله موافقاً للحكم الواقعي، ويكون قدوةً وأُسوةً للأُمّة، تنهل منه، وتستنّ بسنّته، ومشروعية الثورة على هذا الأساس واضحة بيّنة لا تحتاج إلى مزيد بيان.
وفي المبحث الثاني عرفنا أنّ الأُمّة عاشت تحت الاضطهاد والتنكيل، وسُلبت منها الحريّات، وحرّف مسار الشريعة، فكان من الضـروري أنْ يرتفع صوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو فريضة على كافّة المسلمين، وفق شروطٍ معيّنة، فتصدّى لذلك الإمام الحسين×، وأوضح ذلك من خلال خطبه وأقواله.
ومشروعية الثورة وفق هذه الفريضة أيضاً بمستوى من الوضوح؛ إذ إنّ ترك ذلك سيودي بشجرة الإسلام، ويطمس الرسالة المحمدية المباركة من الأساس، فضحّى بنفسه الشريفة من أجل إحياء شريعة المصطفى’.
وفي المبحث الثالث أشرنا إلى أنّ القوانين الوضعية تعطي للمجتمع حقّ الثورة، فيما إذا كانت الحكومة ظالمة متجبّرة، قامعة للحريات، غير مطبِّقة للقوانين، وأوضحنا أنّ الثورة الحسينية تكتسب المشروعية وفق هذه القوانين أيضاً؛ لما كان يعانيه المجتمع من ظلمٍ واستبداد، وقمع للحريات، وتحريف الدستور، واغتصاب الخلافة، وغير ذلك ممّا أوضحناه
الفصل الخامس: مشروعية الثورة وفق بيعة المجتمع الإسلامي للإمام الحسين×
وفق بيعة المجتمع الإسلامي للإمام الحسين×
مؤهّلات الإمام الحسين×للخلافة
لعلّ من نافلة القول البحث عن مؤهّلات الإمام الحسين× وصلاحيته لخلافة الأُمّة الإسلامية، فهو أحد النجوم الساطعة في سماء هذه الأُمّة، وينتمي إلى ذلك البيت الذي لم يفارقه جبرئيل، ولم تفارقه ملائكة الرحمن، فهو خرّيج بيت الوحي ومدرسة الرسالة، نشأ بين أحضان الرسول الأكرم’، وتربّى في كنفه، وارتضع من مكارم أخلاقه؛ لذا سنحاول أنْ نشير مجملاً، ونمرّ مروراً سريعاً على ما يتعلّق بمؤهلاته لخلافة المسلمين.
وطبيعي فنحن هنا لا نريد التعرّض للإمام الحسين× وفق نظريّة النصّ، فإنّ الأمر عند ذلك بيّنٌ واضح، ولكن نريد أنْ نتنزّل وفق مباني المدرسة الأُخرى، وما آل إليه الواقع الخارجي بعد انحراف الأُمّة، وعدم تقيّدها بتوصيات النبيّ الأكرم’ فيما يخصّ أمر الخلافة من بعده، ونرى صلاحيّة الإمام الحسين×، بل أولويته بالخلافة من غيره.
فالحسين من حيث النسب ينتمي إلى قبيلة قريش، وبالتحديد من البيت الهاشمي، ومن أهل البيت^، فنسبه لا يضاهيه نسب في العرب، ولا في المسلمين، فأبوه عليّ بن أبي طالب×، ذلك الأسد الغالب، الذي طالما شهر سيفه دفاعاً عن الدين ورسالته، وهو يُعدّ الخليفة الأوّل طبق نظرية النص، والخليفة الرابع طبق الواقع الخارجي، ووفق متبنيات المدرسة الأُخرى، وقد وردت بحقّه فضائل لا تُعدّ ولا تُحصى، من بينها أنّ النبيّ’ جعله معياراً للحقّ، فقال في ألفاظ عديدة مختلفة، تؤدّي إلى هذا المعنى، منها: «عليّ مع الحقّ والحقّ مع عليّ، ولن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض يوم القيامة[346].
ومنها: «الحقّ مع ذا، الحقّ مع ذا[347].
ومنها: «عليّ مع القرآن والقرآن مع علي، لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض[348].
ولا يخفى على القارئ كثرة الفضائل التي وردت في حقّه×، كحديث الغدير والمنزلة، وتبليغ سورة براءة، وغيرها ممّا امتلأت بها الكتب، وأُلّفت فيها المؤلّفات، فالنسائي له كتاب خاصّ في فضائل عليّ×، أسماه: (خصائص عليّ)، وابن الجزري له كتاب خاصّ، أسماه: (أسنى المطالب في مناقب سيّدنا عليّ بن أبي طالب)؛ ولذا فإنّ جملة من علماء أهل السنّة اعترفوا بأنّ عليّاً هو أكثر الصحابة وردت بحقّه فضائل، فقال أحمد ابن حنبل: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله’ من الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه)[349].
ونقل ابن حجر، عن أبي علي النيسابوري، وأحمد بن شعيب النسائي، وإسماعيل القاضي، وكذلك أحمد بن حنبل، أنّهم قالوا: «لم يرد في حقّ أحدٍ من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ممّا جاء في علي[350].
وأمّا أُمّه فهي فاطمة الزهراء بنت الرسول محمّد’، وفضلها ومناقبها أشهر من أنْ تُذكر، فقد نزل ملك من السماء مبشراً النبيّ’ بأنّ «فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة[351].
وقال لها النبيّ’ في مرضه الذي تُوفّي فيه: «يا فاطمة، ألا ترضين أنْ تكوني سيّدة نساء العالمين، وسيّدة نساء هذه الأُمّة، وسيّدة نساء المؤمنين[352].
وهي بضعةٌ منه’، مَن أغضبها فقد أغضبه، كما في الحديث الشـريف[353]، وإنّ الله يغضب لغضبها ويرضى لرضاها[354]، وكان النبيّ’ إذا سافر فإنّ فاطمة تكون آخر الناس به عهداً، وإذا قدم من السفر كانت أول الناس به عهداً[355].
وممّا تجدر الإشارة به أنّ عليّاً× وفاطمة بنت الرسول’، كانا أحبّ شخصين إلى النبيّ’، كما ورد في الحديث الشـريف، عن بريدة قال: «كان أحبّ النساء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) فاطمة، ومن الرجال عليّ[356].
وحين سأل أحدهم عائشة عن عليّ×، قالت: «تسألني عن رجلٍ ما أعلم أحداً كان أحبّ إلى رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ولا أحبّ إليه من امرأته[357].
بل إنّ الحسين× يعدّ حقيقة ابن الرسول الأكرم’، كما دلّت على ذلك آية المباهلة في قوله تعالى: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) [358].
وفي ذلك يقول الفخر الرازي: «هذه الآية دالّة على أنّ الحسن والحسين‘ كانا ابني رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، وعَدَ أنْ يدعو أبناءه، فدعا الحسن والحسين، فوجب أنْ يكونا ابنيه...[359].
وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية عند بلوغه كلمة (أبناءنا): «(أبناءنا) دليل على أنّ أبناء البنات يُسمّون أبناء، وذلك أنّ النبي (صلّى الله عليه وسلّم) جاء بالحسن والحسين، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفهما، وهو يقول لهم: إن أنا دعوت فأمّنوا...[360].
وأمّا من جهة فضائله ومناقبه فهي أشهر من أنْ تذكر، وقد دأب النبيّ’ أنْ يُشيد بمقامه وينوّه بذكره، ويبيّن للأُمّة عظمته، فكان هو وأخوه الحسن÷ منذ طفولتهما يثبان على ظهر النبيّ’ أثناء الصلاة، وكان الناس يباعدانهما عنه، لكنّ النبيّ’ يرفض ذلك، ويقول: «دعوهما بأبي هما وأُمّي، مَن أحبّني، فليحبّ هذين[361].
وكان النبيّ’ يقول فيه وفي أخيه الحسن÷: «هما ريحانتاي من الدنيا[362].
وفي إشارة جليّة وواضحة من النبيّ’ إلى التكليف الإلهي المرتبط بالحسين× في الحفاظ على الرسالة المحمّدية، قال’: «حسين منّي وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً، حسين سبطٌ من الأسباط[363].
فإنّ كون الحسين× من الرسول’ هو أمرٌ واضح ومعروف؛ باعتبار أنّ الحسين× هو ابن فاطمة‘، وهي بضعة النبيّ الأكرم’، أمّا كون الرسول’ هو أيضاً من الحسين×، فهذا ما يحتاج إلى تفسير وتأمّل، ولا يبعد أنّه إشارة إلى أنّ كليهما يحملان هدفاً واحداً، وغايةً واحدةً، فالرسول جاهد وكافح في سبيل نشر الرسالة الإسلامية وتثبيت أركانها، وتحمّل في سبيل ذلك أنواع الأذى، وعلى نفس الخطّ جاء الابن والامتداد الطبيعي لشجرة الرسالة، ليضحّي بكلّ شيء في سبيل الحفاظ على هذه الرسالة من الطمس والضياع.
كما أنّه لا يخفى على المسلمين وجوب محبّة أهل البيت^، بما فيهم الإمام الحسين× على جميع الأُمّة، فإنّ تلك من الضرورات الإسلامية التي يؤمن بها الجميع.
والحسين× كذلك من أهل البيت^ الذين نزلت في حقّهم آية التطهير، وهي قوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) [364].
ومن أهل البيت^ الذين اصطحبهم النبيّ’ في مباهلة نصارى نجران.
ومن أهل البيت^ الذين وردت الوصيّة بهم، والحث على التمسّك بهم في حديث الثقلين المعروف.
ومن أهل البيت^ الذين ورد في حقّهم حديث السفينة المعروف.
وهكذا، فإنّ فضائل الحسين× كثيرةٌ معروفةٌ مشهودة، ولم يكن ذلك المجتمع ببعيد عن تلك الفضائل، ولم يغِب عن ذهنه يوماً ما مكانة وموقعية الحسين×، فهو من أهل البيت^ من جهة، وصحابي من جهةٍ أُخرى، وكان يمثّل كبار أهل الحلّ والعقد؛ ولذا فإنّ عبد الله بن عمرو بن العاص، كان ذات يوم جالساً في ظلّ الكعبة، إذ رأى الحسين× مقبلاً، فقال: «هذا أحبّ أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم[365].
فالحسين× عاصر أباه عليّاً×، واشترك معه في حرب الجمل وصفّين والنهروان، ثمّ لازم أخاه الحسن× فترة حياته، ثمّ اتجهت نحوه القلوب باعتباره يمثّل البقيّة الباقية من آل بيت الرسول^، ويتمتّع بكافّة الصفات التي وُضعت، أو التي تُوضع لتولّي منصب الخلافة، فهو طبق نظرية النصّ يمثّل إماماً منصوصاً عليه، يتمتّع بالعصمة والعلم والفقاهة، بل يُعدّ أعلم أهل عصره، وأشجعهم وأكفئهم في إدارة الأُمور، إضافةً إلى كونه قرشيّاً هاشميّاً، من أهل بيت النبيّ’.
الحسين وشروط الخلافة عند أهل السنّة
وأمّا طبق الشروط التي يراها علماء أهل السنّة في الخليفة، من العدالة، والعلم، والسياسة، وحسن الرأي والتدبير، والشجاعة، وغيرها ممّا ذكرناها سابقاً في مبحث صفات الحاكم، فهي متوفّرة بأحسن وجوهها عند الإمام الحسين×، ولم ينازع في ذلك أحد، بل نلاحظ حتّى معاوية العدو الشديد لأهل البيت^ كان يعرف في نفسه مقام الحسين×، ومكانته الدينية والاجتماعية، ولذلك حينما كتب إليه الإمام الحسين× كتاباً يبيّن له فيه ظلمه وجوره، وما فعله بشيعة عليّ× وأتباعه، أشار مَن حوله إليه أنْ يجيب الإمام الحسين× بما يصغّر إليه نفسه، فقال لهم معاوية: «وما عسيت أنْ أعيب حسيناً، والله، ما أرى للعيب فيه موضعاً[366]. وفي لفظ البلاذري: «ما عسيت أنْ أقول في حسين، ولست أراه للعيب موضعاً[367].
وكذلك فإنّ معاوية أوصى ولده يزيد بالإمام الحسين×؛ لمعرفته بمنزلته وقدره، وقال له في ذلك: «اُنظر حسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، فإنّه أحبّ الناس إلى الناس[368].
وهذا عبد الله بن مطيع يبيّن منزلة الإمام الحسين× في مجتمعه، وذلك حين التقاه حين الخروج إلى مكّة، ودار بينهم كلامٌ جاء فيه: «جُعلت فداك، أين تريد؟ قال: أمّا الآن فإنّي أُريد مكّة، وأمّا بعدها فإنّي أستخير الله. قال: خار الله لك، وجعلنا فداك، فإذا أنت أتيت مكّة فإياك أن تقرب الكوفة، فإنّها بلدةٌ مشؤومة، بها قُتل أبوك، وخُذل أخوك، واغتيل بطعنةٍ كادت تأتى على نفسه، الزم الحرم، فإنّك سيّد العرب، لا يعدل بك والله، أهل الحجاز أحداً، ويتداعى إليك الناس من كلّ جانب، لا تفارق الحرم فذاك عمّى وخالي، فوالله لئن هلكت لنُسترقنّ بعدك[369]. وفي لفظٍ آخر: «فوالله، لئن قتلك هؤلاء القوم ليتّخذُنّا خولاً وعبيداً[370].
فابن مطيع وهو ممَّن رأى النبيّ’، وعاصر ذلك المجتمع، يوضّح أنّ الحسين× سيّد العرب، ولا يضاهيه أحد من أهل الحجاز، وإنّ الأُمّة ستكون فريسة سهلة بيد الطواغيت، وتتحوّل إلى أُمّة مسترقّة عند فقدان الإمام الحسين×، فابن مطيع يرى أنّ الوجود الحسيني هو وجود حافظ للأُمّة، وبه تُحفظ عزّتها وكرامتها.
ولذا؛ فإنّ أهل السير والتاريخ يذكرون أنّ ابن الزبير قد سبق الإمام الحسين× في دخول مكّة، فلمّا وصل الحسين× إليها، وبقيَ فيها فترة، كان «أثقل خلق الله على ابن الزبير؛ قد عرف أنّ أهل الحجاز لا يبايعونه ولا يتابعونه أبداً ما دام حسين بالبلد، وأنّ حسيناً أعظم في أعينهم وأنفسهم منه، وأطوع في الناس منه[371].
وهذا عبد الله بن جعفر يبيّن عمق المكانة التي يتحلّى بها الإمام الحسين× في المجتمع، فيكتب له متخوّفاً عليه ممّا تؤول إليه الأُمور، فيقول: «فإنّي مشفقٌ عليك من الوجه الذي توجّه له أن يكون فيه هلاكك، واستئصال أهل بيتك، إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض، فإنّك علم المهتدين ورجاء المؤمنين، فلا تعجل بالسير، فإنّي في أثر الكتاب، والسلام[372].
وكذلك فإنّ ابن عبّاس حينما تخوّف على الإمام الحسين× من الخروج إلى العراق، قال له: «فأقم بهذا البلد، فإنّك سيّد أهل الحجاز[373]. وفي لفظٍ آخر أنّه قال له: «وأقم بهذه البلدة، فإنك سيّد أهلها[374].
وحينما انتهت محاورة الإمام الحسين× وابن عبّاس، وانتهت بإصرار الإمام الحسين× على الخروج، وخرج ابن عبّاس من عنده، فمرّ بابن الزبير، فقال له: «قرّت عينك يا بن الزبير بشخوص الحسين عنك، وتخليته إيّاك والحجاز. ثمّ قال:
|
يا
لك من قبّرةٍ بمعمر |
خلا
لك الجوّ فبيضـي واصفري[375]. |
«وكان رجال من أهل العراق وأشراف أهل الحجاز يختلفون إلى الحسين، يجلَّونه ويعظّمونه، ويذكرون فضله، ويدعونه إلى أنفسهم، ويقولون: إنّا لك عضد ويد. ليتّخذوا الوسيلة إليه، وهم لا يشكّون في أنّ معاوية إذا مات لم يعدل الناس بحسينٍ أحداً[376].
ولذا، فحتّى قاتل الحسين× كان يعرف فضله وشرفه ومقامه، فقد جاء في تاريخ الطبري أنّ الذي قتل الحسين× هو سنان بن أنس، فقال له الناس: «قتلت حسين بن علي وابن فاطمة ابنة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قتلت أعظم العرب خطراً، جاء إلى هؤلاء يريد أن يزيلهم عن ملكهم، فأتِ أُمراءك فاطلب ثوابهم، وإنّهم لو أعطوك بيوت أموالهم في قتل الحسين كان قليلاً. فأقبل على فرسه، وكان شجاعاً شاعراً، وكانت به لوثة، فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد، ثمّ نادى بأعلى صوته:
|
أوقر
ركابي فضّةً وذهبا |
أنا
قتلت الملك المحجّبا |
|
قتلت
خير الناس أُمّاً وأباً |
وخيرهم
إذ ينسبون نسباً |
فقال عمر بن سعد: أشهد أنّك لمجنون، ما صحوت قط. أدخلوه عليّ، فلمّا أُدخل حذفه بالقضيب، ثمّ قال: يا مجنون، أتتكلّم بهذا الكلام، أما والله، لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك[377].
فمن الواضح إذاً أنّه لا يوجد تشكيك في مكانة الحسين× وعلوّ مقامه، وهو سيّد أهل الحجاز، وهو أحبّ الناس إلى الناس، كما ورد في لفظ الفرزدق وكذلك معاوية[378]، فالخلافة هي من تتشرّف بالإمام الحسين×، لا هو يتشرّف بها، فأولويته على أهل زمانه من الصحابة وغيرهم من الصلحاء لا كلام فيه، فما بالك بأولويته من يزيد بن معاوية مع فسقه وفجوره وانحلاله؛ لذا من الطبيعي أنْ تميل القلوب إليه، وأنْ تكتب الكتب والرسائل تدعوه إلى القدوم، ليقيم الحقّ ويدحض الباطل.
وطبيعيٌّ أنّ الحسين بما يمثّله من امتداد للنبوة، ومن كبار أهل البيت^، ومن أجلّة أهل الحلّ والعقد، ما كان ليقف مكتوفاً أمام صرخات الناس ودعواتهم إليه، ليقودهم بسفينته نحو برّ الأمان، فكانت كتب القوم ورسائلهم هي أحد الأسباب التي دعت الإمام الحسين× للتحرّك؛ لذا كان لا بدّ من الوقوف على حقيقة هذه الرسائل وعددها، ومقدار ما تحويه من معانٍ أدّت بالحسين× إلى الخروج صوب العراق، وهذا ما سنبيّنه في المبحث اللاحق إنْ شاء الله.
المبحث الثاني
رسائل أهل الكوفة والبصرة وانعقاد البيعة للحسين×
من الواضح أنّ الحسين بن علي× يمثّل ثقل أهل البيت^ في وقته، فهو البقيّة الباقية بعد رحيل أبيه عليّ×، ثمّ رحيل أخيه الحسن×، فكانت الأنظار ترنو إليه، وتتمنّى أنْ تتخلّص من الظلم الذي حاق بها من بني أُميّة، ولم يكن هناك مَن يستطيع أنْ يقود الأُمّة ويرسو بها إلى برّ الأمان غير الإمام الحسين×؛ لما يتمتّع به من مواصفات، وما يحمله من مؤهّلات، سواء على المستوى النسبي أو ما جاء في حقّه من فضائل بثّها النبيّ’ في المجتمع الإسلامي، أو لما يحمله من علوم جدّه’، أو ما يتمتّع به من خُلقٍ رفيع استقاه من ذلك البيت، الذي كان مهبطاً للوحي، ومنطلقاً للرسالة.
وقد بدأت بوادر البيعة للإمام الحسين× بعد وفاة الإمام الحسن×، فقد روى البلاذري بإسنادٍ جمعي: «أنّه لمّا توفي الحسن بن عليّ اجتمعت الشيعة، ومعهم بنو جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي، وأُمّ جعدة أمّ هانئ بنت أبي طالب، في دار سليمان بن صرد، فكتبوا إلى الحسين كتاباً بالتعزية، وقالوا في كتابهم: إنّ الله قد جعل فيك أعظم الخلف ممَّن مضى، ونحن شيعتك المصابة بمصيبتك، المحزونة بحزنك، المسرورة بسرورك، المُنتظرة لأمرك.
وكتب إليه بنو جعدة يخبرونه بحسن رأي أهل الكوفة فيه، وحبّهم لقدومه وتطلّعهم إليه، وأن قد لقوا من أنصاره وإخوانه مَن يرضى هديه، ويطمأنّ إلى قوله، ويعرف نجدته وبأسه، فأفضوا إليهم ما هم عليه من شنآن ابن أبي سفيان، والبراءة منه، ويسألونه الكتاب إليهم برأيه.
فكتب (الحسين×) إليهم: إنّي لأرجو أنْ يكون رأي أخي (رحمه الله) في الموادعة، ورأيي في جهاد الظلمة رشداً وسداداً، فالصقوا بالأرض، وأخفوا الشخص، واكتموا الهوى، واحترسوا من الأظَّاء ما دام ابن هند حيّاً، فإنْ يحدث به حدث وأنا حيّ يأتِكم رأيي إنْ شاء الله[379].
ونقل الشيخ المفيد عن الكلبي والمدائني: أنّه بعد وفاة الإمام الحسن× «تحرّكت الشيعة بالعراق، وكتبوا إلى الحسين× في خلع معاوية والبيعة له، فامتنع عليهم، وذكر أنّ بينه وبين معاوية عهداً وعقداً لا يجوز له نقضه حتّى تمضي المدّة، فإنْ مات معاوية نظر في ذلك[380].
وقد يبدو هذا الاعتذار من الإمام الحسين× متناقضاً مع ما أوضحناه سابقاً، من أنّ معاوية قد أخلّ بشـروط الهدنة، وأنّ للإمام الحسين× الحقّ في الخروج.
لكنّ هذا التناقض غير تامّ، وقد أجبنا عنه سابقاً، وعرفنا هناك أنّ ظروف المجتمع الإسلامي لم تتغيّر كثيراً بما يتناسب مع القيام بثورة، فمعاوية هو هو، والمجتمع هو هو، ولم تحصل تلك التغييرات التي تتيح للإمام الحسين× القيام بثورة منتجة على مرّ الأزمان، وأنّ شروط الصلح وإنْ نكثها معاوية فإنّ ذلك لم يصل إلى جميع أمصار العالم الإسلامي، مع ملاحظة أنّ السلطة وجانبها الإعلامي كان بيد معاوية، وبإمكانه أنْ يغيّر الحقائق، ويبثّ في المجتمع بولاياته المختلفة أنّ الحسين× نقض الشروط، وخالف الهدنة وخرج للقتال، خصوصاً أنّ أهمّ بنود الصلح لم تُنقض بعد، وهو أنّ الخلافة تعود للإمام الحسن×، ثمّ للحسين×؛ لأنّ معاوية وقتها لم يبايع لولده يزيد بولاية العهد.
وعلى كلّ حال فقد كانت بذرة البيعة وكتابة الرسائل إلى الإمام الحسين’ بعد وفاة الإمام الحسن×.
ثمّ إنّ معاوية بايع لولده يزيد بولاية العهد كما أسلفنا سابقاً، وبدأت المعارضة لسياسته تتّسع وتزداد، وكان الإمام الحسين×على هرم المعارضين، وكذلك معه عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وبعد وفاة معاوية كان همّ يزيد أنْ يأخذ البيعة ممَّن لم يبايعوا سابقاً، خصوصاً الحسين× وابن الزبير، ممّا اضطر الإمام الحسين× لترك مدينة جدّه رسول الله’، والرحيل إلى مكّة، وهناك بدأت الرسل تتوافد إليه، نشير إليها فيما يلي:
1ـ الظاهر أنّ أوّل رسالة وصلت إلى الحسين× في مكّة كانت بتاريخ: 10رمضان من عام 60 للهجرة، وذلك حين بلغ الشيعة خبر موت معاوية، وعدم مبايعة الحسين ليزيد، وجاء فيها: «من سليمان بن صرد، والمسيّب بن نجبة، ورفاعة بن شدّاد، وحبيب بن مظهر... وشيعته من المؤمنين والمسلمين من أهل الكوفة، أمّا بعد، فالحمد للَّه الذي قصم عدوّك الجبّار العنيد، الذي انتزى على هذه الأُمّة، فابتزّها أمرها، وغصبها فيئها، وتأمّر عليها بغير رضًى منها، ثمّ قتل خيارها، واستبقى شرارها، وجعل مال الله دولةً بين أغنيائها، فبُعداً له كما بَعُدت ثمود، وليس علينا إمام، فاقدم علينا، لعلّ الله يجمعنا بك على الحق.
واعلم أنّ النعمان بن بشير في قصـر الإمارة، ولسنا نجمع معه جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد، ولو بلغنا إقبالك إلينا أخرجناه فألحقناه بالشام، والسلام[381].
وبعثوا هذه الرسالة مع عبد الله بن سبيع الهمداني، وعبد الله بن وال التيمي، وأوصلوها إلى الإمام الحسين× في العاشر من شهر رمضان[382].
وكما هو واضح تضمّنت هذه الرسالة عدّة نقاط أساسية:
الأُولى: إنّ الشيعة في الكوفة كانوا لا يرون مشروعية خلافة معاوية بن أبي سفيان، وأنّه غاصب مبتزّ لأمر هذه الأُمّة، ومُتأمّرٌ عليها بقوة السيف، دون رضىً منها.
الثانية: إنّ معاوية لم يحكم في الأُمّة بالعدل والأنصاف، بل ساسها بقوّة السيف، فقتل خيارها واستبقى أشراراها، وتسلّط على أموال المسلمين، ولم يقتسمه بالحقّ، بل كان يصـرف على أغنيائها يتداولونه بينهم، وأمّا الفقراء والمتعفّفين من هذه الأُمّة فليس لهم شيء.
الثالثة: إنّهم لم يبايعوا يزيد بن معاوية، وباقون بلا إمام عليهم، ولم يجتمعوا مع والي الكوفة لا في جمعة ولا في جماعة، ويطلبون من الإمام الحسين× القدوم ليقيم الحقّ، ويدفع الباطل.
الرابعة: إنّه في حالة علمهم بقدوم الإمام الحسين×، فإنّهم سينتفضون على النعمان بن بشير والي الكوفة، ويخرجوه إلى الشام حيث مقرّ الحكم الأُموي.
وطبيعي أنّ هذه الأُمور كفيلة لتحريك أي إنسان رسالي يطمح في إقامة حكم الله بالأرض.
2ـ بعد يومين من الرسالة الأُولى أخذ الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة يكتبون إلى الإمام الحسين×، فأرسلوا قرابة الخمسين صحيفة، بعثوها بيد قيس بن مسهر بن خليد الصيداوي من بني أسد، وعبد الرحمان بن عبد الله بن الكدر الأرحبي، وعمارة بن عبد السلولي[383].
وفي إرشاد المفيد نقلاً عن أهل السير والتاريخ: إنّ عدد الصحف بلغت نحو مائة وخمسين صحيفة[384].
3ـ ثمّ لبثوا يومين آخرين وسرّحوا إليه هانئ بن هانئ السبيعي، وسعيد بن عبد الله الحنفي، وكتبوا معهما: «أمّا بعد، فحيّهلا، فإنّ الناس منتظرون لك، لا إمام لهم غيرك، فالعجل ثمّ العجل ثمّ العجل، والسلام[385]. وفي لفظ الطبري: «أمّا بعد، فحيّهلا، فإنّ الناس ينتظرونك، ولا رأي لهم في غيرك، فالعجل العجل، والسلام عليك[386].
وهذه الرسالة أيضاً صريحة ومؤكّدة لما قبلها بأنّ القوم لم يبايعوا ليزيد، وأنّهم بلا إمام، وينتظرون من الحسين× القدوم بالسـرعة الممكنة؛ ليقيم لهم الحقّ، ويخلصّهم ممّا هم فيه من الظلم.
4ـ وكتب له مجموعة من أهل الكوفة، وهم: شبث بن ربعي اليربوعي، ومحمّد بن عمير بن عطارد بن حاجب التميمي، وحجار بن أبجر العجلي، ويزيد بن الحرث بن يزيد ابن رويم الشيباني، وعزرة بن قيس الأحمسي، وعمرو بن الحجاج الزبيدي، كتاباً جاء فيه: «أمّا بعد، فقد اخضـرّ الجناب، وأينعت الثمار، وكلمت الجمام، فإذا شئت فاقدم علينا، فإنّما تقدم على جندٍ لك مجنّدة!!! والسلام[387].
وجاء في بعض الرسائل أنّ لك بالكوفة مائة ألف، ذكر ذلك الطبري بطريقين عن حصين بن عبد الرحمن، قال: «إنّ الحسين بن عليّ×، كتب إليه أهل الكوفة أنّه معك مائة ألف[388].
وقد ذكر سبط ابن الجوزي ذلك أيضاً، وذكر رسالة أهل الكوفة الناصّة على ذلك، والمختلفة قليلاً عن الرسالة الأُولى في اللفظ، وإنْ كان الظاهر هي نفس الرسالة، فقد ذكر نقلاً عن الواقدي: أنّه «لمّا استقرّ الحسين× بمكة وعلم به أهل الكوفة، كتبوا إليه يقولون: إنّا قد حبسنا أنفسنا عليك، ولسنا نحضـر الصلاة مع الولاة، فاقدم علينا فنحن في مائة ألف، وإنّا قد فشا فينا الجور، وعُمل فينا بغير كتاب الله وسنّة رسوله، ونرجو أن يجمعنا الله بك على الحق، وينفي عنا بك الظلم، فأنت أحقّ بهذا الأمر من يزيد وأبيه الذي أغضب الله فيها، وشرب الخمور، ولعب بالقرود والطنابير وتلاعب الدين، وكان ممَّن كتب إليه ذلك: سليمان بن صرد، والمسيب بن نجيبة، ووجوه أهل الكوفة[389]. «فتتابعت عليه في أيام رسل أهل الكوفة، ومن الكتب ما ملأ منه خرجين[390].
وقد اجتمعت هذه الرسائل والكتب عند الإمام الحسين×، فقرأها وسأل الرسل عن أمر الناس، ثمّ كتب مع هانئ بن هانئ السبيعي، وسعيد بن عبد الله الحنفي: «بسم الله الرحمن الرحيم، من حسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أمّا بعد، فإنّ هانئاً وسعيداً قدما عليّ بكتبكم، وكانا آخر مَن قدم عليّ من رسلكم، وقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلّكم: إنّه ليس علينا إمام، فأقبل لعلّ الله أنْ يجمعنا بك على الهدى والحقّ. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمّى وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم، فإنْ كتب إليّ أنّه قد أجمع رأيُ مَلَئكم، وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت عليّ به رسلكم، وقرأت في كتبكم؛ أقدم عليكم وشيكاً إنْ شاء الله، فلعمري، ما الإمام إلّا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحقّ، والحابس نفسه على ذات الله، والسلام[391].
وهذه الرسالة تتضمّن استجابة صريحة من الإمام الحسين× لدعوة مجتمع الكوفة، عند بقاء ملئهم وأهل الفضل والحجى منهم على موقفهم من نصـرة الإمام×، مشفوعة بذكر أسباب ذلك، وهي انحراف الخليفة والإمام المتولّي لزمام الأُمور عن أداء مهامّه ووظائفه التي أُوكل بها، من العمل بكتاب الله وسنّة نبيّه، وإقامة العدل بين الناس، والالتزام بالحقّ، وحبس النفس على ذات الله، لا إغراقها في الشهوات والملذّات.
ولمّا وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة، نزل في دار المختار بن أبي عبيد، وأقبلت الشيعة تختلف إليه، فكلّما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم كتاب الحسين بن علي÷ وهم يبكون، وبايعه الناس حتّى بايعه منهم ثمانية عشـر ألفاً، فكتب مسلم& إلى الحسين×، يخبره ببيعة ثمانية عشـر ألفاً، ويأمره بالقدوم[392].
وجاء في الكتاب الذي أرسله إليه: «إنّ الرائد لا يكذب أهله، وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألف رجلٍ، فأقدم، فإنّ جميع الناس معك، ولا رأي لهم في آل أبي سفيان[393].
وكان الحسين× في الطريق، فكتب إليهم كتاباً بيد قيس بن مسهر الصيداوي، جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين والمسلمين، سلام عليكم، فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أمّا بعد، فإنّ كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب بحقّنا، فسألت الله أنْ يحسن لنا الصنع، وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر، وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم التروية، فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشوا أمركم وجدّوا، فإنّي قادم عليكم في أيامى هذه إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[394]. وفي لفظٍ آخر: «بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين بالكوفة، سلام عليكم، أمّا بعد، فإنّ كتاب مسلم بن عقيل ورد عليّ باجتماعكم لي، وتشوّقكم إلى قدومي، وما أنتم عليه منطوون من نصـرنا، والطلب بحقّنا، فأحسن الله لنا ولكم الصنيع، وأثابكم على ذلك بأفضل الذخر، وكتابي إليكم من بطن الرّمة، وأنا قادمٌ عليكم، وحثيث السير إليكم، والسلام[395].
والكتاب صريح في أنّ التحرّك كان استجابةً لطلب أهل الكوفة، ودعوتهم الحسين× لنصرته.
وربّما على ضوء تلك الرسائل فإنّ الإمام× أخذ يعدّ العدّة والعدد للقيام بثورته، ويستنصر المسلمين ويدعوهم إلى الالتحاق به، وإنْ كان سلام الله عليه موقن بحسب ما يستقرأه من وضع الساحة، وبحسب ما وردته من نصائح بأنّ ذلك لا يتمّ، لكن الظروف الظاهرية كانت تحتّم عليه أنْ يقوم بدوره، ويهيّئ لثورته هذه ما تحتاج إليه من عدّة وعدد، فكتب في ذلك إلى أشراف أهل البصرة كتاباً جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى مالك بن مسمع، والأحنف بن قيس، والمنذر بن الجارود، ومسعود بن عمرو، وقيس بن الهيثم، سلام عليكم، أمّا بعد، فإنّي أدعوكم إلى إحياء معالم الحقّ وإماتة البدع، فإنْ تجيبوا تهتدوا سبل الرشاد، والسلام[396].
وقد تقدّم منّا ذكر رسالة الإمام الحسين× إلى وجهاء وأشراف أهل البصرة، بلفظٍ آخر، جاء فيه: «أمّا بعد، فإنّ الله اصطفى محمّداً (صلّى الله عليه وسلّم) على خلقه، وأكرمه بنبوّته، واختاره لرسالته، ثمّ قبضه الله إليه، وقد نصح لعباده، وبلّغ ما أُرسل به (صلّى الله عليه وسلّم) وكنّا أهله وأولياءه، وأوصياءه وورثته، وأحقّ الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا بذلك، فرضينا وكرهنا الفرقة، وأحببنا العافية، ونحن نعلم أنّا أحقّ بذلك الحقّ المستحقّ علينا ممَّن تولّاه... وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه (صلّى الله عليه وسلّم) فإنّ السنّة قد أُميتت، وإنّ البدعة قد أُحييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدِكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله[397]. وهذه الرسالة حوت على مضامين عديدة تمّت الإشارة إليها سابقاً.
ومن بين الوجهاء الذين وصلتهم رسالة الإمام الحسين× غير ما ذكرناه، يزيد بن مسعود النهشلي[398]، وعمرو بن عبيد الله بن معمر[399].
ولم يسعفنا التاريخ ببيانٍ مُفصّل حول موقف جميع أشراف أهل البصرة من هذه الرسالة، إلّا أنّه من الواضح أنّ بعضهم قد تأرجح موقفه مثل الأحنف بن قيس، الذي كتب إلى الإمام الحسين×: «أمّا بعد، فاصبر إنّ وعد الله حقّ، ولا يستخفنّك الذين لا يوقنون[400].
وبعضهم قد خان الأمانة وهو المنذر بن الجارود، فأفشى السـرّ دون غيره؛ بحجّة خوفه أنْ يكون الرسول دسيساً من ابن زياد، فقام بتسليمه إليه، وأقرأه كتابه، فقُدّم الرسول وضُربت عنقه[401].
ومنهم مَن استجاب بأهله وذويه وعشيرته لطلب الإمام الحسين×، وكان موقفه مشرّفاً، وهو يزيد بن مسعود، فجمع بنى تميم وبنى حنظلة وبنى سعد، وحثّهم على الجهاد والقتال مع الحسين×، فاستجابوا له، وأبدوا استعدادهم للقتال والشهادة بين يديه، فكتب إلى الحسين× يخبره بطاعتهم له، واستعدادهم للقدوم والجهاد بين يديه، فدعا له الحسين× خيراً، لكن الأقدار غيّبت هذه الثلّة من أهل البصرة عن حضور كربلاء، ونيل شرف الشهادة بين يدي أبي عبد الله، بعد أنْ وصلهم خبر استشهاده في حال جهازهم للمسير إليه[402].
هذا، وكان قد اجتمع إلى الحسين× في مدّة مقامه بمكة نفرٌ من أهل الحجاز، ونفرٌ من أهل البصرة، انضافوا إلى أهل بيته ومواليه[403].
وذكر أبو المخارق الراسبي أنّه اجتمع ناس من الشيعة بالبصـرة في منزل امرأة من عبد القيس، يُقال لها: مارية ابنة سعد، أو منقذ، أياماً وكانت تتشيّع، وكان منزلها لهم مألفاً يتحدّثون فيه، وقد بلغ ابن زياد إقبال الحسين×، فكتب إلى عامله بالبصرة أن يضع المناظر، ويأخذ بالطريق، قال: فأجمع يزيد بن نبيط وهو من عبد القيس الخروج إلى الحسين×، وكان له بنون عشـرة، فقال: أيّكم يخرج معي؟ فانتدب معه ابنان له: عبد الله وعبيد الله، فخرجوا والتحقوا بالحسين× في الطريق، ثمّ استشهدوا معه يوم عاشوراء، رغم ممانعة الآخرين لهما، وتخوّفهما عليهما من ابن زياد[404].
والخلاصة؛ إنّ هناك حاكماً جائراً متربّعاً على كرسي الخلافة بغير وجهٍ وحقّ، وهناك مجتمع يتظلّم ويشكو ما حلّ به من الظلم والجور، والابتعاد عن القرآن والسنّة، وهناك بيعة ورسائل وكتب تدعو الإمام الحسين× للقدوم، وترى فيه المنقذ والمخلّص من هذا الظلم والجور، وهناك أنصار أخرون انضمّوا لقافلة الحسين× من المدينة ومكّة والبصرة، فتكون عناصر الثورة قد اكتملت، ولا مناص للإمام الحسين× ـ باعتباره يمثّل ثقل أهل البيت^، وامتداد النبوّة ـ إلّا أنْ يستجيب لهذه الدعوات، ويلبّي تلك الصـرخات، فتحرّك باتجاه الكوفة؛ لإقامة العدل والقضاء على الجور والباطل، متّخذاً من هذه الرسائل حجّة كافية على مشروعية تحرّكه، فكان في أكثر من مناسبة يحتجّ على مشروعية تحرّكه بالرسائل التي وصلته من القوم، وهذا ما سنوضّحه فيما يأتي:
احتجاج الإمام الحسين× برسائل أهل الكوفة
عرفنا أنّ شرارة الثورة الحسينية انطلقت في المدينة، حين وفاة معاوية، وتربّعِ يزيد على سدّة الحكم، بعد أنْ مهّد له أبوه معاوية ذلك بشـراء الضمائر وقوّة السيف، فكان همّ يزيد عند تولّيه الخلافة أنْ يأخذ البيعة ممَّن رفضوا ذلك، وعلى رأسهم الإمام الحسين×، وعبد الله بن الزبير.
فراسل يزيد واليه على المدينة في أخذ البيعة منهم، فرفضوا ذلك وانطلقوا إلى مكّة؛ باعتبارها حرماً آمناً.
وقد عرفنا سابقاً أنّ مشروعية الثورة قائمة من حين نكث معاوية لشـروط الصلح مع الإمام الحسن×؛ لأنّ معاوية لم يكتسب أيّ مشـروعية لحكمه وخلافته عندها، مضافاً لابتعاد سلوكياته وحكمه عن الشريعة المقدّسة، فكان يتّبع سياسة التجويع والإرهاب والإقصاء، وقتل الصلحاء، وغير ذلك من الجور والظلم الذي كان يقوم به.
وأشرنا سابقاً إلى الأسباب التي منعت الإمام الحسين× من التحرّك ضدّ معاوية بعد وفاة الإمام الحسن×، والتي منها قوّة السلطة الإعلامية التي يمتكلها معاوية، وسطوته الكبيرة على المجتمع الإسلامي، كانت تمكّنه من تشويه الحقائق وتصوير الحسين× بأنّه خارج عن القانون، وناكث لشـروط الصلح والهدنة، وبالتالي القضاء على ثورته من دون أيّ ثمارٍ تذكر.
فلمّا توفي معاوية بدأت الأُمور تتجلّى أوضح، فمجيء يزيد إلى سدّة الخلافة بالصورة التي بيّناها سابقاً يتنافى صراحةً مع شروط الهدنة، وهذا يبرّر بحدّ ذاته تحرّك الإمام الحسين× لاستعادة الحقّ المغتصب، هذا من جهة، وإنّ يزيد كان متجاهراً بالفسق مستهتراً بالسنّة متحلّلاً عن القيم والمبادئ، فهو لا يمتلك الشرائط الشرعية لخليفة المسلمين، وهذا مبرّر آخر للتحرّك وإنقاذ المسلمين من تبعات ذلك، هذا من جهةٍ ثانية، فكان من أولويات الإمام الحسين× أنْ لا يُعطي لهكذا خلافة أيّ شرعية تُذكر، فبدأ ثورته برفض البيعة ليزيد، مؤكّداً أنْ لا بقاء للإسلام مع هكذا خلافة، فراح يبيّن فسق الخلافة من جهة، والدعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهةٍ أُخرى، وهذه الأُمور كما أوضحنا كلّها تكسب الثورة مشروعية مستقلّة، فكيف إذا انضمّ إلى ذلك بيعة المجتمع الإسلامي، ودعواته المتكرّرة إلى الإمام الحسين×، باعتباره مُخلّصاً ومنقذاً للأُمّة من الانحراف الذي حلّ بها، فرسائل أهل الكوفة وبيعتهم له أعطت زخماً جديداً للثورة الحسينية، وأكّدت مشـروعية التحرّك؛ إذ لا يمكن للحسين× السكوت والأُمّة تستصرخه وتندبه للقدوم؛ لذا كان يحتجّ في أكثر من موطن برسائل وكتب أهل الكوفة إليه، نقف على عدّة من ذلك:
1ـ يقول أحد الرواة: «رأيت أبنية مضروبة بفلاة من الأرض، فقلت: لمَن هذه؟ قالوا: هذه لحسين. قال: فأتيته فإذا شيخ يقرأ القرآن، قال: والدموع تسيل على خدّيه ولحيته، قال: قلت: بأبي وأمّي يا بن رسول الله، ما أنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد؟ فقال: هذه كتب أهل الكوفة إليّ، ولا أراهم إلّا قاتليّ، فإذا فعلوا ذلك لم يدَعوا لله حرمة إلّا انتهكوها، فيسلّط الله عليهم مَن يذلّهم...[405].
فالإمام× هنا يبيّن للسائل بأنّه إنّما يتحرّك وفق البيعة والرسائل التي وصلته من أهل الكوفة، على الرّغم من قرائته للأحداث بأنّ النتيجة ستكون القتل، فإنّ هدف الإمام كما أوضحنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمّا الرسائل والبيعة فقد زادت من تكليف الإمام×، وأكدّت المسؤولية عليه، وكان لا بدّ له من التعامل معها كما هي.
2ـ ورد أنّ ابن عمر لمّا سمع بخروج الحسين× إلى العراق، لحقه على مسيرة ثلاث ليالٍ، ونهاه عن الخروج، فأجابه الإمام الحسين×: بأنّ «هذه بيعتهم وكتبهم. يقول الخبر: «فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل، والسلام[406].
فالإمام الحسين× هنا يبيّن أنّ سبب خروجه لهم هو البيعة والرسائل التي وصلته منهم.
3ـ لمّا التقى به جيش الحر، وصلّى بهم الإمام× صلاة الظهر، قام خطيباً فيهم بعد ذلك، فقال: «أيّها الناس، معذرةً إلى الله، ثمّ إليكم، إنّي لم آتكم حتّى أتتني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم، فإنْ أعطيتموني ما أطمئنّ إليه من عهودكم ومواثيقكم دخلنا معكم مِصـركم، وإنْ تكن الأُخرى انصـرفت من حيث جئت. فأسكت القوم، فلم يردوا عليه، حتى إذا جاء وقت العصر نادى مؤذن الحسين×، ثمّ أقام، وتقدّم الحسين×، فصلّى بالفريقين، ثمّ انفتل إليهم، فأعاد مثل القول الأول[407].
وفي لفظٍ أنّ الحسين× حمد الله وأثنى عليه، وقال: «أمّا بعد، أيّها الناس، فإنّكم إنْ تتّقوا وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله، ونحن أهل البيت أولى بولايته هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدّعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان، وإن أنتم كرهتمونا وجعلتم حقّنا[408]، وكان رأيكم غير ما أتتني كتبكم، وقدمت به عليّ رسلكم، انصـرفت عنكم[409]. فقال الحر بن يزيد: «والله، ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر. فقال الحسين×: ائتني بالخرجين اللذين فيهما كتبهم. فأُتي بخرجين مملوءين كتباً، فنُثرت بين يدي الحر وأصحابه، فقال له الحر: يا هذا، لسنا ممَّن كتب إليك شيئاً من هذه الكتب، وقد أُمرنا ألّا نفارقك إذا لقيناك، أو نقدم بك الكوفة على الأمير عبيد الله بن زياد، وقد رأيتُ رأياً فيه السلامة من حربك، وهو أن تجعل بيني وبينك طريقاً، لا تدخلك الكوفة، ولا تردّك إلى الحجاز، تكون نصفاً بيني وبينك، حتى يأتينا رأي الأمير...[410].
ويمكن أنْ نلاحظ على هذا الخبر ما يلي:
أ ـ إنّ الحسين× احتجّ على القوم برسائلهم، وأكّد في إقامة الحجّة عليهم بطلبه الانصراف عند تخلّيهم عن وعودهم ورسائلهم، مع علمه ومعرفته بأنّ القوم لا يقنعون منه بالرجوع من دون بيعة؛ لذا أراد من خلال طلبه الانصراف أنْ يؤكّد مشروعية خروجه أمام الرافضين لذلك، والناصحين له بالرجوع، ويقول لهم بأنّ المسألة لا تتعلّق بخروجي وعدمه، وإنّما تتعلّق بأصل البيعة، ومَن مثلي لا يمكن أن يبايع مثل يزيد ويُضفي عليه الشرعية؛ لذا فإنّ قتلي محتوم لا محالة، والقتل بثورة ورفض لهذا التسلّط والظلم والجور خيرٌ من قتلٍ باغتيال بارد، لا يحرّك من عزيمة المجتمع، ولا يوضّح فساد وجبروت حكم بني أُميّة.
ب ـ إنّ الحرّ لم يستطع الإجابة عن احتجاج الإمام الحسين× عليهم بالرسائل إلّا بصفة الإنكار ودعوى عدم معرفته بالرسائل، وحين أخرج له الإمام الحسين× خرجين من الرسائل بادر الحر بإنكار أنْ يكونوا ممَّن كتبوا ذلك، وهذا يُنبئ عن وجود ارتكاز عند الحر وجيشه، بأنّ وجود الرسائل يُعطي شرعية لتحرّك الحسين× وقدومه، ولا يمكن لأحد أنْ يُنكر عليه ذلك التحرّك مع هذا الكمّ الهائل من تلك الرسائل.
4ـ خطب الإمام الحسين× في جيش الحر خطبة أُخرى في منطقةٍ تُدعى: (البيضة)، جاء فيها: «أيها الناس، إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال: مَن رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله، ناكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قولٍ، كان حقّاً على الله إن يدخله مدخله، ألا وإنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّموا حلاله، وأنا أحقّ مَن غيّر، وقد أتتني كتبكم، وقدمت عليّ رسلكم ببيعتكم، أنّكم لا تسلّموني ولا تخذلوني، فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم، فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، نفسـي مع أنفسكم، وأهلي مع أهليكم، فلكم فيّ أُسوة، وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم، وخلعتم بيعتي من أعناقكم، فلعمري، ما هي لكم بنكر، لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمّى مسلم، والمغرور من اغترّ بكم، فحظّكم أخطأتم، ونصيبكم ضيّعتم، ومَن نكث فإنّما ينكث على نفسه، وسيغنى الله عنك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته[411].
وفي هذه الخطبة نلاحظ طريقة جديدة، فلم نرَ هنا طلباً من الإمام× في الرجوع وترك المسير، بل ركّز على جوانب أُخرى، أهمّها:
أ ـ تأكيده× على مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع انحراف السلطان وتبديله السنن، بتحريمه حلال الله وتحليله حرامه، وإطاعته للشيطان، وإظهاره الفساد في الأرض..
ب ـ بيان موقعيّته فيهم، وأنّه أحقّ مَن يغيّر هذا الواقع المنحرف.
ج ـ تذكيرهم ببيعتهم ورسائلهم إليه، واحتجاجه عليهم بها، وأنّ البقاء على البيعة والوفاء بهذا العهد هو سبيل الرشاد، مؤكّداً لهم أنّه ـ وهو الحسين بن علي وابن فاطمة بنت الرسول ـ سيكون معهم بنفسه وعياله، وعليهم أنْ يتأسّوا به.
د ـ حذّرهم من مغبّة عدم الوفاء بالبيعة والعهد الذي أعطوه له، ومن عقاب الله لهم، وأنّ الناكث إنّما ينكث على نفسه، والله غنيٌّ عن العالمين.
وهذه الصيغة الجديدة في الخطاب تؤكّد أنّ طلب الرجوع إنّما كان من باب الاحتجاج وبيان حقيقة الأمر، فإنّ القوم لن يتركوا الحسين× من دون بيعة، ولذا فإنّه اتّخذ من رسائلهم وبيعتهم حجّة قويّة على مشـروعيّة تحرّكه، مضافاً لمشروعيّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدّ ذاته، فإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون مع وجود الأعوان والأنصار أشدّ وآكد، فالحسين× بعد أنْ طلب منهم الانصراف في خطبته السابقة لهم، لم يطلبه هذه المرّة، بل أدخل العنصر الأساس الذي تحرّك على ضوئه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطلب منهم الوفاء بعهودهم والاستمرار على بيعتهم؛ لأنّ ذلك هو سبيل الرشاد.
5ـ حينما كان الإمام الحسين× في الطريق وانتهى إلى ماء من مياه العرب، وكان هناك عبد الله بن مطيع العدوي، فلمّا رأى الحسين× قام إليه، فقال: بأبي أنت وأُمّي يا ابن رسول الله، ما أقدمك؟ واحتمله فأنزله، فقال له الحسين×: «كان من موت معاوية ما قد بلغك، فكتب إليّ أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. فقال له عبد الله بن مطيع: أذكّرك الله يا بن رسول الله، وحرمة الإسلام أن تُنتهك، أُنشدك الله في حرمة رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، أُنشدك الله في حرمة العرب، فوالله، لئن طلبت ما في أيدي بنى أُمية ليقتلنّك، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً أبداً، والله إنّها لحرمة الإسلام تُنتهك، وحرمة قريش وحرمة العرب، فلا تفعل ولا تأتِ الكوفة، ولا تعرض لبنى أُميّة، قال: فأبى إلّا أنْ يمضي[412].
وفي هذا اللقاء أيضاً نجد أنّ الإمام الحسين× برّر خروجه بكتب أهل الكوفة وبيعتهم، ولم يثنِه كلام ابن مطيع من إخباره بما سوف يجري، بل إنّ كلام ابن مطيع وكلام الكثير الذين حاوروا الحسين× لم يكن ليقدح بمشروعية خروجه مع وجود الكتب والرسائل، بل كانوا متخوّفين من خيانة أهل الكوفة، فالكتب والرسائل كانت تعطي مشروعية للتحرّك، سواء كان في نظر الحسين× أو في نظر الصحابة والتابعين، وهذا ما نريد أنْ نؤكّد عليه.
6ـ ما ورد عن الفرزدق حين خرج مُريداً الحج، فلمّا وصل ذات عرق، رأى قباباً مضروبة، فقال: لمَن هذه؟ قالوا: «للحسين بن علي. يقول: «فعدلت إليه فقلت: يا بن رسول الله، ما أعجلك عن الحج؟ قال: كتب إليّ هؤلاء القوم ـ يعني أهل الكوفة ـ يذكرون ما هم فيه[413].
وهنا أيضاً فإنّ الإمام الحسين× يكتفي في تبرير خروجه برسائل وكتب أهل الكوفة.
7ـ لمّا بعث ابن زياد عمر بن سعد في أربعة آلاف، وأمره أنْ يسير إلى الحسين×، فلمّا نزل بإزائه أرسل قرّة بن قيس الحنظلي إلى الحسين×؛ ليسأله عن سبب مجيئه، فأجابه الحسين: «كتب إليَّ أهل الكوفة في القدوم إليهم، فأمّا إذ كرهوني فإنّي أنصرف عنهم[414].
فرجع قرّة وأخبر ابن سعد بذلك، فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد: «بسم الله الرحمن الرحيم، أمّا بعد، فإنّى حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عمّا أقدمه وماذا يطلب ويسأل، فقال: كتب إلى أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم، فسألوني القدوم ففعلت، فأمّا إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا منصرف عنهم، فلمّا قرئ الكتاب على ابن زياد قال:
الآن
إذ علقت مخالبنا به |
يرجو
النجاة ولات حين مناص. |
فكتب ابن زياد إلى ابن سعد: «أمّا بعد، فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرت، فاعرض على الحسين أنْ يبايع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا، والسلام[415].
وهذه المراسلات تبيّن احتجاج الإمام الحسين× بكتب أهل الكوفة ورسلهم، وتؤكّد ما ذكرناه سابقاً بأنّ القوم لن يرضوا من الحسين× بغير بيعة يزيد، وهو أمر لا يمكن أنْ يتمّ ويصدر من الإمام الحسين×؛ لأنّ معناه إضفاء الشرعية على خلافة يزيد، وهي خلافة بعيدة عن الإسلام، بل بوجودها يتمّ القضاء على ما تبقّى من مبادئ وقيم إسلاميّة، ومبايعة الحسين× تكون حينئذٍ مساهمة منه في القضاء على الإسلام، وهذا لا يمكن أنْ يصدر منه؛ لذا فهو يلقي الحجج تلو الحجج عليهم بطلبه الرجوع؛ حتّى يتبيّن للمجتمع أنّ ما سيحصل من انتهاك لحرمة الحسين× ليس سببه الخروج والتحرّك، بل إنّ الحسين× خرج أو لم يخرج فإنّ مصيره القتل إنْ لم يبايع.
8 ـ خطب الإمام الحسين× يوم عاشوراء خطبةً طويلة مؤثّرة، عرّفهم بنفسه ونسبه وفضائله، ثمّ ختم بقوله: «أتطلبوني بقتيلٍ منكم قتلته، أو مالٍ لكم استهلكته، أو بقصاصٍ من جراحة. قال: فأخذوا لا يكلّمونه، قال: فنادى يا شبث بن ربعي، ويا حجّار بن أبجر، ويا قيس ابن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إليّ أن قد أينعت الثمار، وأخضرّ الجناب، وطمت الجمام، وإنّما تُقدم على جندك لك مُجنّد، فأقْبِلْ. قالوا له: لم نفعل. فقال: سبحان الله، بلى والله، لقد فعلتم. ثمّ قال: أيّها الناس، إذ كرهتموني فدعوني أنصـرف عنكم إلى مأمني من الأرض[416].
وفي هذه الخطبة تأكيد واحتجاج آخر على القوم برسائلهم وكتبهم، ولذا فقد بادر هؤلاء الذين استحكم الشيطان من قلوبهم وعقولهم إلى تكذيب ذلك؛ لأنّ الإقرار به يتنافى مع ما يقومون به من قتاله، ثمّ إنّه× ألقى الحجّة مرّة أُخرى في تلك اللحظات العصيبة، وطلب منهم الإنصراف، لكنّهم وكما ذكرنا كانوا مصرّين على البيعة، لذا أجابه قيس بن الأشعث أخو محمّد بن الأشعث الذي تلطخت يداه بدم مسلم عقيل، فقال: «أولا تنزل على حكم بنى عمّك فإنّهم لن يروك إلا ما تحبّ ولن يصل إليك منهم مكروه. فقال له الحسين: «أنت أخو أخيك أتريد أنْ يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل، لا والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرّ إقرار[417] العبيد، عباد الله إنّي عذت بربّي وربّكم أنْ ترجمون، أعوذ بربّي وربّكم من كلّ متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب[418].
فالإمام الحسين× لا يمكن أنْ يبايع ولا أن يستسلم لقوات ابن زياد، فالخضوع لهؤلاء يمثل الذلّ والهوان، والحسين× خرج ليحرّر الناس ويخلّصهم من تجبّر وكبرياء الظالمين، لا أنْ يكون كغيره خاضعاً لهم، وكان مجيؤه بناءً على كتبهم ورسائلهم؛ لذا بقي على موقفه صامداً مكافحاً حتّى قضـى شهيداً مضمّخاً بدمه، ليبقى صدى صوته، يقضّ الظلمة ويهزّ عروش الظالمين، وتبقى قطرات دمه الطاهرة مشعلاً وضّاءً ينير درب البشـرية، ويعلّمها معنى التحرّر ورفض قيود ذلّ وعبودية الظالمين.
وللإمام× خطب وأقوال أُخرى صريحة في الاحتجاج عليهم برسائلهم وكتبهم.
والخلاصة التي نريد أنْ نصل إليها أنّ نفس رسائل القوم وبيعتهم للإمام الحسين× واستصراخهم له قد أوجبت عليه التحرّك والقدوم، وإنْ كان يعرف بحسب الظروف أنّ النتيجة لا تنتهي بالنصـر العسكري، إلّا أنّ اعتلاء سدّة الخلافة من شخص لا يملك أدنى مكوّناتها، ولم تُراعَ في تنصيبه أقلّ شروطها، مع الظلم المتفشّي، واندثار السنة، وانتشار البدعة، واستصـراخ القوم للحسين×، وطلبهم القدوم لينتصروا به على الظلم والعدوان، وإقامة الحقّ والعدل، وإحياء السنة وإماتة البدعة، كلّ ذلك كان يحتّم على الإمام الحسين× الخروج والتحرّك إلى الكوفة. فهناك بيعة وكتب ورسائل، وهناك حاكم لا يتمتّع بالشرعية، ويحكم بالجور والباطل، وهناك إمام مجمع على عدله وعلمه وصلاحيته لخلافة الأُمّة وقيادته، وهو الإمام الحسين×، وقد بُويع من قبل الآلاف المؤلّفة عن طوعٍ واختيار، فلا بدّ عليه من الاستجابة والقيام، وهو ما حصل.
ولذا فإنّ الكثير من الصحابة والتابعين يرون صواب ثورة الحسين×، ولم يقدحوا بشرعيتها، بل كانوا خائفين عليه من خيانة أهل الكوفة وغدرهم به، وإلّا فكلّهم كانوا يرون أحقيّة الإمام الحسين× وأولويّته في الخلافة، وأنّ الحق معه، وقد ورد عن مروان الأصفر، قال: حدّثني الفرزدق، قال: «لمّا خرج الحسين، لقيت عبد الله بن عمرو، فقلت: إنّ هذا قد خرج، فما ترى؟ قال: أرى أنْ تخرج معه، فإنّك إنْ أردت دنيا، أصبتها، وإنْ أردت آخرة أصبتها. فرحلت نحوه، فلمّا كنت في بعض الطريق، بلغني قتله، فرجعت إلى عبد الله، وقلت: أين ما ذكرت؟ قال: كان رأياً رأيته.
قال شمس الدين الذهبي معلّقاً على هذا الخبر: «هذا يدلّ على تصويب عبد الله بن عمرو للحسين في مسيره، وهو رأي ابن الزبير وجماعة من الصحابة شهدوا الحرّة[419].
ونختم هذا المبحث باحتجاجه× في يوم عاشوراء على أهل الكوفة، حين خطب فيهم خطبةً عظيمة، وبّخهم فيها على غدرهم وخيانتهم، قال (سلام الله عليه): «تبّاً لكم أيّتها الجماعة وترحاً! أحين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفاً لنا في أيمانكم، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم ألباً لأعدائكم على أوليائكم، بغير عدلٍ أَفشَوه فيكم، ولا أملٍ أصبح لكم فيهم، فهلّا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن، والرأي لمّا يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدّبا، وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، ثمّ نقضتموها، فسحقاً لكم يا عبيد الأُمّة! وشذاذ الأحزاب، ونَبَذة الكتاب، ومحرّفي الكلم، وعصبة الآثام، ونفثة الشيطان، ومُطفئي السنن، ويحكم! أهؤلاء تعضدون، وعنّا تتخاذلون، أجل والله، غدرٌ فيكم قديم، وشجت عليه أُصولكم، وتأزّرت فروعكم، فكنتم أخبث ثمر شجًى للناظر وأكلةٍ للغاصب! ألا وإنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منّا الذلة يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجورٌ طابت وطهرت، وأنوفٌ حميّة، ونفوسٌ أبيّة، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإنّي زاحفٌ بهذه الأسرة على قلّة العدد، وخذلان الناصر. ثمّ أنشد أبيات فروة بن مسيك المرادي:
|
فإن
نَهزم فهزّامون قدماً |
وإن
نُهزَم فغير مهزّمينا |
|
وما
إن طبنا جبن ولكن |
منايانا
ودولة آخرينا |
|
فقل
للشامتين بنا أفيقوا |
سيلقى
الشامتون كما لقينا |
|
إذا
ما الموت رفع عن أناس |
بكلكله
أناخ بآخرينا |
أما والله لا تلبثون بعدها إلّا كريثما يُركب الفرس، حتى تدور بكم دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور، عهدٌ عهده إلىّ أبي، عن جدّي رسول الله، (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ) [420]،( إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)[421][422].
شبهة أنّ التحرّك الحسيني وفق الرسائل يتنافى مع استمراره بالتحرّك، رغم علمه بخيانة أهل الكوفة:
قد يُقال: إنّ الحسين× استمرّ بالخروج حتى بعد وصول خبر مقتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة، وهذا يتنافى مع كون تحرّكه كان استجابةً لبيعتهم إيّاه، فبعد غدرهم وقتلهم بوكيله وممثّله مسلم، لم يبقَ له مبرّر في الاستمرار؟!
1ـ ذكرنا في بحثنا هذا أنّ دواعي تحرّك الإمام الحسين× كانت متعدّدة ومتنوّعة ولم تكن مقتصرة على أمرٍ معيّن، فيزيد لم يكن مؤهّلاً للخلافة، ولم يتمتّع بصفاتها، ولم يكن تنصيبه تنصيباً شرعيّاً، بل إنّ أباه لم يكن خليفة شرعياً، وكانا يسوسان البلاد بقوّة السيف، فالخروج متعيّن لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولاستعادة الخلافة المُغتصبة والمتنافية مع نظريتي النصّ والشورى، على حدٍّ سواء. فلو فرضنا أنّ البيعة أصبحت لاغية بعد علم الإمام الحسين× بمقتل مسلم، فإنّ بقيّة المبرّرات موجودة، بل إنّ قتل مسلم وهاني بالطريقة الوحشية التي ذُكرت هي مبرّر آخر للخروج وعدم السكوت على إجرام هؤلاء الطغاة.
2ـ لو فرضنا أنّ البيعة كانت المحرّك الوحيد، فإنّ وصول خبر مقتل مسلم لا يكفي لوحده في الانسحاب، ما لم يصل إليهم الإمام الحسين× ويحتجّ عليهم بكتبهم ورسائلهم؛ لأنّ رجوعه قد يُسجّل عند البعض هو انهزام وخيانة لمَن بايعوه، وكتبوا له ذلك بالقول إنّ تأثير الإمام الحسين× أكثر بكثير من تأثير مسلم، ولو كان قد ذهب إليهم لتغيّرت الأُمور، والتحق به القوم وتحقّق النصر. ويؤيّد هذا الاحتمال ما قاله بعض الأصحاب للإمام الحسين× عند وصول خبر مقتل مسلم: «إنّك والله، ما أنت مثل مسلم ابن عقيل، ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع[423].
ثمّ إنّ الصورة كانت ضبابية ولم تتّضح الأُمور بصورة كليّة، فغاية ما وصل للإمام× من خبر أنّ هناك خيانة، وأنّ مسلم وهاني قُتلا. أمّا أين بقيّة الأصحاب، وما حلّ بهم؟! فهذا ما لم يصله، خصوصاً أنّ هناك من خيرة الصحابة والذين التحقوا بمعركة عاشوراء منهم مسلم بن عوسجة، وأبو ثمامة الصائدي؛ فلذا كان من الضرورة أنْ يستمرّ الإمام الحسين× بالتحرّك ليقف على الأُمور بنفسه، وليلقي الحجّة عليهم.
3ـ إنّ أصل التحرّك الحسيني ومغادرة المدينة المنورة كان مبتنياً على عدم مبايعة يزيد، وهذه المسألة كانت بمثابة الخط الأحمر؛ لأنّ البيعة تعني القضاء على الإسلام بمباركة حسينية، وهذا يستحيل وقوعه من الإمام الحسين×، لذا تخوّف الإمام الحسين× من قتله في المدينة فرحل إلى مكّة، وتخوّف من قتله في مكّة فرحل صوب العراق استناداً إلى الرسائل، وكان لا يشكّ بأنّ مصيره القتل إذا لم يبايع[424]، فلمّا أرسل مسلم لأهل الكوفة وعلم بقتله لاحقاً كان ذلك مؤشّراً واضحاً على دقّة تشخيصه ومعرفته بنوايا القوم[425]، و أنّه لا محالة من القتل إنْ لم يبايع، فحينئذٍ هو مخيّر بين أمرين: الرجوع والقتل باغتيال أو سمّ بطريقة لا تؤثّر في المجتمع، أو الاستمرار في إلقاء الحجّة والتذكير بحقّه وحقّ أهل البيت^ في الخلافة، ودعوة الناس إلى إقامة الحقّ والعدل، ونبذ الظلم والجور المتمثّل في حكم بني أُميّة، فكان الخيار الثاني هو خيار كلّ صاحب مبدأ، فكيف بالإمام الحسين× الممثّل لأهل البيت^ومن خيرة أهل الحلّ والعقد في وقته. وقد ذكرنا سابقاً أنّ الإمام× صرّح بأنّ القوم سيقتلونه لا محالة، وذلك قبل وصول خبر مقتل مسلم إليه، فبعد وصول خبر مسلم تكون المسألة أوضح.
مشروعية الثورة قانوناً وفق بيعة أهل الكوفة
من الواضح أنّ الجنبة القانونية المتعلّقة بهذا المبحث هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما تقدّم من كلام حول البيعة وشرائط الخليفة الإسلامي.
وقد عرفنا هناك أنّ الخلافة الإسلامية لها شرائط معيّنة، ولا يمكن أنْ يعتلي هذا المنصب الخطير كلّ مَن هبّ ودبّ، وأوضحنا أنّ هذه الشـرائط بعضها يتعلّق بشخص الخليفة، كالعدالة والعلم وحسن التدبير وغيرها، وبعضها يتعلّق بطريقة التنصيب، من وجود بيعة له من المجتمع، أو لا أقلّ من أهل الحلّ والعقد، وكونها بالاختيار لا بالقهر والغلبة، وعدم استغلال السلطة المال العام، ولا الإرهاب والقتل والتشريد والتهديد في طريقة أخذ البيعة وغيرها، وبيّنا أنّ يزيد بن معاوية لم تتحقّق فيه أيٌّ من تلك الشـرائط، سواء المتعلّقة بشخص الخليفة أو بكيفيّة البيعة والتنصيب.
كما قمنا بعملية إسقاط قانوني على تلك الفترة، وذكرنا أنّ القوانين الوضعية أيضاً لها شرائط في شخص الرئيس، كبلوغه سن معيّنة مثلاً، وشرائط في طريقة تنصيبه، كأنْ يكون بالاقتراع السرّي المباشر، وأنْ يكون هذا الاقتراع نزيهاً، وغير ذلك ممّا أشرنا إليه سابقاً، واتّضح أنّ يزيد بن معاوية لا تنطبق عليه الشرائط القانونية، لا من جهة المؤهّلات والصفات الذاتية، ولا من جهة طريقة الانتخاب.
وما نودّ إضافته في هذا المبحث أنّه على خلاف يزيد بن معاوية، فإنّ الحسين بن علي تنطبق عليه الشرائط سواء الشرعية أو القانونيّة وفي كلا الجهتين، كذلك سواء في شرائط ومؤهلات الشخص المرشّح للخلافة أم في كيفيّة التنصيب وطريقة الانتخاب.
فمن جهة المؤهّلات عرفنا أنّ الحسين× يمثّل القمّة في أهل الحلّ والعقد في زمانه، فهو تنطبق عليه شرائط الخليفة الشرعي، ولو قمنا بإسقاط قانوني لكانت النتيجة كذلك فإنّ الشرائط منطبقة عليه.
ومن جهة البيعة وطريقة التنصيب، فالبيعة لم تحصل ليزيد وخالفه ثلّة من أهل الحلّ والعقد، وقد استخدم معاوية المال العام والترهيب والترغيب في سبيل أخذ البيعة له، ثمّ اعتلى بعد ذلك عرش الخلافة بعد موت أبيه معتمداً على تلك البيعة، فاستخدم سلطته في أخذ بيعة من بايعه بعد ذلك.
أمّا الإمام الحسين× فبايعته الناس عن قناعة ورضا، وكتبوا إليه يستصرخونه ويستنجدونه، ويطلبونه إماماً وخليفة عليهم، مصرّحين بأنّه ليس عليهم إمام ولا خليفة.
فهذه البيعة الاختيارية من وجهاء وكبار وغالبية أهل الكوفة تمثّل الانتخابات من الوجهة القانونية في أزماننا، وهي متحقّقة الشـرائط من الاختيار، والحريّة، وعدم استخدام القوّة ولا المال العام، ولا غير ذلك ممّا يقدح في قانونيتها، فقلوبُ الناس كانت بطبيعتها تهفو إلى الإمام الحسين×، عارفين وموقنين بأنّ العدل لا يتحقّق إلّا على يديه، وحتّى بعد ما حصل الغدر وانقلبت الأُمور، فإنّما هو من الخوف والإرهاب المتمثّل في حكومة يزيد المتسلّطة على رقاب الأُمة بلا مسوّغٍ شرعي أو قانوني، وهذا ما أفصحه الفرزدق فيما ذكرناه سابقاً، من أنّ الناس قلوبهم مع الحسين× وسيوفهم مع بني أُميّة.
والغرض أنّ الإسقاط القانوني ليس فقط يُنتج عدم قانونية وشرعية خلافة يزيد، بل يُثبت قانونية وشرعية خلافة الحسين بن عليّ×؛ لما يمتلكه من مؤهّلات أقرّ بها كبار قومه، ولما تحقّق من بيعة اختيارية صدرت عن رضًى وقناعة تامّة. وحينئذٍ تكون مبرّرات الثورة القانونية متحقّقة. فالمتسلّط على كرسي الرئاسة شخصٌ غاصب لها بقوّة السيف، لا يملك مؤهّلاتها، ولم تنتخبه الأُمّة.
والذي يمتلك المؤهّلات وانتخبته الأمّة مُبعَد عن مكانه المُفترض، فكان طبيعياً أنْ لا يحصل الغاصب المتسلّط على تأييد وانتخاب له ممَّن يرى أنّ هذا حقٌّ له، فإنّ هذا الرفض لبيعة يزيد في جنبته القانونية فضلاً عن دخوله في الحريّة الشخصية في الانتخاب من عدمه، وفضلاً عن كونه يمثل وقوفاً بوجه الخرق الدستوري الحاصل من الرئيس نفسه، فهو رفض قانونيٌّ مبتنٍ على كونه مدعوماً ومؤيّداً من مئات الآلاف من الجماهير التي أعطت صوتها له على أنّه هو الرئيس الذي ينبغي أنْ يرسو بالأُمّة نحو شاطئ الأمان، فتكون الثورة من حكومة منتخبة مُبعدة بقوّة السيف على حكومة قامت بخرق الدستور واستولت على مقدّرات الأُمّة بغير وجه حقّ، فهو تصدٍّ من أصحاب الحقّ ضدّ الخارجين على القانون.
تركّز البحث في هذا الفصل على مشروعية الثورة وفق بيعة أهل الكوفة للإمام الحسين×، من خلال الرسائل التي أرسلوها إليه يدعونه فيها للقدوم؛ لما يرونه من الظلم والتجبر الذي يزاوله الحكم الأُموي، وعدم مشـروعية خلافة يزيد بن معاوية، وأنّهم ليس عليهم إمام يأخذ بأيديهم إلى برّ الأمان، فذكرنا عدّة من هذه الرسائل، بعد أنْ استعرضنا موجزاً عن مؤهّلات الإمام الحسين× للخلافة، من خلال موقعيّته الكبيرة في الأُمّة الإسلامية، وعرفنا أنّه لا يشكّ أحد في ذلك، فالكلّ كان مذعناً بمكانة الحسين× وأهليّته وأولويّته من يزيد في الخلافة، خصوصاً أنّ الفضائل التي وردت في حقّه من الرسول الأكرم’ عديدة جدّاً.
وأوضحنا بعد ذلك أنّ الإمام الحسين× بنفسه قد صرّح بمشروعيّة ثورته وفق رسائل أهل الكوفة إليه، فاحتجّ في أكثر من موضع سواء على أهل الكوفة أو على الرافضين لخروجه بهذه الرسائل والكتب التي وصلت إليه، ثمّ أقام تمام الحجّة على القوم، بعد أنْ ذكّرهم برسائلهم، وطلب منهم الانصـراف إنْ تغيّر رأيهم، ولم يفوا بعهدهم.
وتطرّقنا في آخر الفصل إلى إشكاليةٍ قد تواجه هذا الطرح، متمثّلة بعدم رجوع الحسين× بعد سماعه وعلمه بمقتل مسلم بن عقيل، باعتبار أنّ القوم نقضوا البيعة واستحلّوا دماء أهل البيت^، وعرفنا أنّ هذه الإشكالية غير تامّة؛ لعدم توقّف الخروج على وجود هذه الرسائل، ولعدم كفاية مقتل مسلم ابن عقيل في طرح آلاف الرسائل المبايعة؛ لعدم وضوح الرؤية بصورة تامّة، مع وجود ثلّة من المخلصين الذين لا يُتوقّع منهم الخيانة، ولإمكان القول بأن تأثير الحسين× أكثر من مسلم، وبوجوده سيتغيّر الوضع تماماً هذا ثانياً، ولأنّ الحسين× عارف بأنّ القوم لا يتركونه دون بيعة، فإمّا أنْ يبايع أو يُتقل، وطبيعيٌّ أنّ القتل بمواجهة الظالمين وإعلاء كلمة الحقّ بطريقة مؤثّرة بالأُمّة أفضل بكثير من قتلٍ بارد، يسبقه انسحاب من المواجهة.
الفصل السادس: دلائل قرآنية ونبوية على مشروعية ثورة الإمام الحسين×
على مشروعية ثورة الإمام الحسين×
تمهيد
لا نهدف من هذا الفصل تناول الآيات القرآنية والروايات النبوية المنادية بالوقوف بوجه الظالمين وعدم الخضوع لهم، وضرورة إقامة القسط العدل في ربوع الأرض، وغيرها ممّا يتعلّق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو آيات وروايات الجهاد، أو قتال البُغاة، وغيرها، بل نريد الخروج عن واقع الأحداث بعيداً عن ظروف المجتمع الإسلامي في تلك الحقبة، ونسلّط الضوء على مجموعة من النصوص الشرعية؛ لنرى من خلالها وفي ضوئها هل يمكن القول بعدم مشروعية الثورة، أم إنّ تلك النصوص لوحدها كافية في تحديد هوية الثورة وكسبها الشرعية.
والنصوص التي سنتناولها في هذا الفصل هي نوعان:
النوع الأوّل: تلك النصوص التي تفيد أنّ الحسين× إمامٌ منصوص عليه من السماء.
النوع الثاني: النصوص الدالّة على فضائله، ويمكن من خلالها الحكم على ثورته.
لذا سيكون هذا الفصل في مبحثين، نُلقي من خلالهما الضوء على مشروعية الثورة.
الثورة الحسينية وفق نظرية النص
من غير الخفيّ ما حصل للأُمّة الإسلامية من انقسام بعد وفات نبيّها الأكرم’، إذ ترى مدرسة أهل البيت^ أنّ الخلافة تنعقد بالنصّ الشـرعي، ولا دخل للبشر في تعيينها أو تحديدها مهما بلغ من النضوج الفكري أو الثقافي، بينما ترى مدرسة الصحابة أنّ تعيين الخليفة إنّما هو من شؤون الأُمّة الإسلامية، ولا يوجد نصّ شرعي في تحديد الخليفة.
وقد ولّد هذا الانقسام تبايناً واسعاً في فهم الدين، إذ ترتكز مدرسة أهل البيت^ في استقائها للعقائد والأحكام والأخلاق، وسائر الشؤون الدينية على أهل البيت^ أنفسهم، ويرونهم الطريق والمنبع الصحيح لاستقاء سنّة النبيّ’، بينما ترى المدرسة الأُخرى أنّ المنبع الأساس والصحيح لمعرفة سنّة النبيّ’ هو طريق الصحابة.
ومن الواضحّ أنّ ما بيّناه في الفصول السابقة، إنّما هو بمعزل عن كون الإمام الحسين× إماماً منصوباً من السماء، ومُفترض الطاعة على المسلمين، بل كان وفق السياقات الخارجية التي وقعت على الأُمّة الإسلاميّة، وغيّرت مسارها بعد أنْ تولّى أبو بكر ثمّ عمر ثمّ عثمان خلافة المسلمين، بالكيفيّة التي أوضحناها سابقاً، ثمّ تولّى الخلافة عليّ، وبعده الحسن استناداً للبيعة الواقعة خارجاً، لا وفق النصّ الشرعي، وما تلى ذلك من أحداث بيّناها في ما مضى.
إلّا أنّنا في هذا المبحث نريد أنْ نخرج عن الواقع الخارجي، ونتكلّم وفق النظرية التي نعتقد أنّها النظرية التي أرادها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي نظرية النصّ، لنرى مشروعية الثورة على ضوء ذلك.
وقد تقدّم في الفصل الأوّل الكلام مختصراً عن نظرية النص، وأوضحنا هناك أنّه طبقاً للأدلّة الصحيحة فإنّ الإمامة منحصرة في أهل البيت^، وقد تناولنا بعض الأدلّة العامةّ الشاملة لأهل البيت^، وبعض الأدلّة الخاصّة الواردة في إمامة عليّ×.
ومن الواضح أنّه طبق نظرية النصّ، فإنّ الإمام الحسين× هو أحد الأئمّة المنصوص عليهم من السماء، فهو الخليفة الشرعي الواجب على الأُمّة طاعته والسير وفق توجيهاته.
ومن الأدلّة التي سِيقت لإثبات ذلك هو: حديث الثقلين، وهو قوله’ ـ على ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد وزيد بن أرقم ـ: «إنّي تاركٌ فيكم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي; أحدهما أعظم من الآخر; كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض، فاُنظروا كيف تخلفوني فيهما[426]. وورد أيضاً بلفظ: «ما إنْ أخذتم به[427]. وبلفظ: «إنّي تركت فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض[428].
وقد تقدّم ذكر طرق أُخرى للحديث سابقاً، وأوضحنا أنّها عديدة متظافرة، حتّى قال بعضهم بتواتره، والحديث صريح في خلافة أهل البيت^، ووجوب الأخذ منهم، واقتفاء أثرهم، وأنّ الاستقامة على جادّة الشريعة وعدم الضلال موقوف على التمسّك بهم، وألفاظه بيّنة في ذلك، فاُنظر قوله: «إنّي تركت فيكم خليفتين. الصريح في أنّ أهل البيت خلفاء النبيّ’، وقوله: «إنّي تاركٌ فيكم ما إنْ تمسّكتم به لن تضلّوا بعدي. وقوله: «ما إنْ أخذتم به.... فهي ألفاظ صريحة في أنّ التمسّك بأهل البيت^، والأخذ منهم مُنجي من الضلال، ومُوجب للهداية.
وقد أوضحنا سابقاً أنّ الحديث يدلّ على عصمة أهل البيت^ أيضاً؛ لقرنهم بالقرآن الكريم، وعدم افتراقهم عنه، والقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ولأنّ الأمر بالتمسّك بهم جاء مطلقاً، من دون قيود، ممّا يدلّل على أنّ جميع أقوالهم وأفعالهم وتصرّفاتهم موافقة للشريعة الإسلامية.
فالحديث إذن يمثلّ أحد النصوص على خلافة أهل البيت^، ووجوب اتّباعهم، وبضميمة أنّ الحسين× من أهل البيت^، فيكون حينئذٍ أحد خلفاء النبيّ’ المنصوص عليهم، وسنُبيّن بعد قليل أنّ النبيّ’ بيّن المراد من أهل بيته^، كما في حديث الكساء.
ومن الأدلّة العامّة الواردة في خلافة أهل البيت^ ووجوب اتّباعهم هو حديث السفينة، وهو قوله’: «مَثل أهل بيتي فيكم، مَثل سفينة نوح مَن ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق.
وهذا الحديث رواه عدّة من الصحابة، وقفنا على ثمانية منهم، وهم: عليّ بن أبي طالب[429]، وعبد الله بن الزبير[430]، وعبد الله بن عبّاس[431]، وأبو ذر الغفاري[432]، وأبو سعيد الخدري[433]، وأنس بن مالك[434]، وأبو الطفيل[435]، وسلمة بن كهيل[436].
ورُوي الحديث عنهم بطرق عديدة بلغت آحاد إسنادها إلى عشـرة طرق، مع احتساب الأسانيد المختلفة الدائرة على راوٍ واحد طريقاً واحداً، وكذلك من دون ملاحظة تعدّد الطبقات في السند الواحد، ما دام يدور على راوٍ واحد، وإلّا فطبقات الرواة أكثر من ذلك بكثير، فقد بلغ طبقة الرواة الذين نقلوا الحديث عن الصحابة (15) راوٍ، وبلغت الطبقة التي تليها (16) راوٍ، وبلغت الطبقة التي بعدها (15) راوٍ، وبلغت التي بعدها (19) راوٍ، ثمّ أخذت بالتزايد أكثر، ودُوّن الحديث في الكتب والمصنّفات واشتهر وانتشر[437].
وقد صرّح جملة من العلماء بصحّة أو حسن هذا الحديث، كالحاكم[438]، والسخاوي[439]، وابن حجر الهيتمي[440]، وغيرهم.
وما أفادوه هو الذي عليه التحقيق العلمي، فإنّ بعض طرقه صحيحة أو حسنة، هذا فضلاً عن تعاضدها مع بعضها البعض.
ويدلّ الحديث على وجوب اتّباع أهل البيت^ واقتفاء أثرهم، سواء كان في العقائد أو الأحكام، وسائر الأُمور الدينية؛ ذلك أنّ النبيّ’ شبّههم بسفينة نوح، وسفينة نوح كانت عنوان النجاة لَمن ركبها، ولم يكن في ذلك الوقت سبيل للخلاص من الهلاك غير ذلك، فتشبيه أهل البيت^ بها؛ يدلّ على أنّ النجاة تتحقّق بالرجوع إليهم، والانتهال من معينهم.
وحيث إنّ سفينة نوح كانت الملاذ الأوحد للنجاة حين تلاطمت الأمواج، ولم يجدوا عاصماً غيرها حتى الجبال الرواسي، فكذلك أهل البيت^، هم الملاذ الأوحد عند تلاطم أمواج الفتن، واختلاف الآراء، وتشعّب النظريات، وهذا يدلّ على أنّ الحديث يفيد حصر الاتّباع بأهل البيت^؛ لأنّ تشبيههم بالسفينة يلغي وجود احتمال آخر؛ فالإنسان إمّا أنْ يركب السفينة أو لا يركبها ولا يوجد سبيل ثالث، فالراكب فيها أي المتّبع لأهل البيت^ ينجو، وغير الراكب فيها يهلك ويغرق، فسبيل النجاة منحصر بهم لا غير.
وهذا المعنى الذي ذكرناه واضحٌ بيّن من التشبية، لا ينكره إلاّ مكابر، ولذا نجد الإمام مالك بن أنس يشبّه السنّة النبوية بأنّها سفينة نوح، فقد أخرج الخطيب بسنده إلى ابن وهب، قال: «كنّا عند مالك فذكرت السنّة، فقال مالك: السنّة سفينة نوح، مَن ركبها نجا، ومَن تخلّف عنها غرق[441].
وهذا يعني أنّ الإمام مالك يرى أنّ التشبيه بسفينة نوح يدلّ على وجوب الاتّباع والاقتفاء، ولذا شبّه السنّة بها، وهو تشبيه دقيق لا يختلف فيه اثنان؛ إذ إنّ الشيعة يرون أنّ المنبع الذي يمثّل السنّة النبوية الصحيحة هم أهل البيت^.
وكذلك فإنّ الحديث يدلّ على عصمة أهل البيت ^؛ إذ إنّ النبيّ’ جعل النجاة وتحصيل رضا الله ودخول الجنة مقروناً بركوب سفينتهم، واتّباع أوامرهم واجتناب نواهيهم، وهذا يلزم منه عدم صدور الخطأ والذنب والعصيان منهم، وإلّا لزم منه عدم النجاة لمتّبعيهم؛ إذ كيف يُتصوّر النجاة مع إمكان ارتكابهم للمعاصي والذنوب؟!
فدلّ التشبيه المذكور على أنّ كلّ أقوالهم وأفعالهم موافقة للشريعة المقدّسة، وأنّهم لا يحيدون عنها طرفة عين، وإلّا لا يتحقّق الفوز ولا النجاة باتّباعهم.
فالفوز والنجاة المقترن بالتمسّك بأهل البيت^، وضلالة وهلاك المنحرف عنهم يدلّ على عصمتهم، وأنّ سفينتهم سائرة على الصراط المستقيم.
ومن خلال وجوب اتّباعهم والقول بعصمتهم يتّضح أنّ قيادة الأُمّة وإقامة العدل فيها، وإنصاف المظلوم، وردع الظالم، وإقامة الحدود والتعزيرات، وتشخيص القيام بالحروب أو الصلح، والفصل في القضاء، وغيرها ممّا يتعلّق بأُمور الحكم والسياسة، إنّما ذلك من وظائف الإمام×؛ إذ لا معنى مع كونه معصوماً أنْ يتصدّى لهذه الأُمور غيره ممَّن يجوز عليه الخطأ والنسيان، فإنّ ذلك لا يحقّق العدل، ولا يدفع الباطل، كما أنّ وجوب طاعتهم مطلقاً يقتضـي التسليم بكلّ أفعالهم وأقوالهم، بما في ذلك ما يتعلّق بالأُمور السياسية وشؤون الحكم والسلطان، فلا معنى للدخول في حرب مع تشخيص الإمام× عدم الصلاح في ذلك، ولا معنى للتسليم بقضاء مع وجود رؤية مغايرة للإمام× في ذلك، وهكذا فما دام الإمام× واجب الطاعة وكونه معصوماً من الخطأ وجب الرجوع إليه في كلّ كبيرة وصغيرة، بما في ذلك الشؤون السياسية.
ولم تقتصر استفادة العصمة على الحديثين السابقين، بل دلّت عليها آيات وروايات أُخرى، أبرزها آية التطهير، وهو قوله سبحانه وتعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) [442].
وفي استفادة العصمة من هذه الآية، واختصاصها بأهل البيت^ كُتبت الكتب والمقالات، ولا نريد الخوض في ذلك مجدّداً، بل نشير فقط إلى أنّ القول بالعصمة يلازمه ضرورة الاتّباع؛ لأنّ معنى العصمة هو موافقة أعمالهم وأقوالهم لما عليه الشرع الحكيم في نفس الأمر والواقع، وإذا كانت أعمالهم وأقوالهم مطابقة للشـرع الحكيم وجب على الأُمّة التمسّك والأخذ بها، والانتهال من معينها، وعدم جواز مخالفتها.
وممّا يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [443]، المنسجمة في معناها مع آية التطهير، حيث تدلّ على وجود مجموعة معيّنة متّصفين بالصدق في كلّ أفعالهم وأقوالهم، وتُوجب على المؤمن الكون معهم، فهي تدلّ على عصمتهم وعلى وجوب اتّباعهم.
وإذا كانت الخلافة والإمامة في أهل البيت^ فمن الواضح شمول هذا الاصطلاح ـ أعني اصطلاح أهل البيت^ ـ للإمام الحسين×، فلا يشكّ أحد في أنّ الإمام الحسين× هو أحد أفراد أهل البيت^، خصوصاً أنّ النبيّ’ صرّح بذلك في مناسبات عديدة، نقتصـر هنا على نموذجين من حديث الكساء الوارد في تفسير آية التطهير:
1 ـ أخرج مسلم بسنده إلى عائشة، قالت: «خرج النبي (صلّى الله عليه وسلّم) غداةً، وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمّ جاء الحسين فدخل معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ جاء علي فأدخله، ثمّ قال: إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً[444].
2 ـ أخرج الترمذي بسنده إلى شهر بن حوشب، عن أُمّ سلمة، قالت: «إنّ النبي جلّل على الحسن والحسين وعلي وفاطمة كساء، ثمّ قال: اللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي[445]، أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فقالت أُمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنّك إلى خير. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب[446].
فالحسين بن عليّ× هو أحد أهل البيت^ الذين نزلت فيهم آية التطهير، وورد فيهم حديث الثقلين، وحديث السفينة، وغير ذلك ممّا تكفّلته البحوث المختصّة بذلك.
وإذا كان الإمام الحسين× هو إمام منصوصٌ عليه، ومُفترض الطاعة من قِبل الله سبحانه تعالى، فإنّ مشروعية ثورته من الوضوح بمكان، فإنّه طبقاً لهذه النظرية أنّ الأئمّة معصومون، والمعصوم لا يرتكب الخطأ ولا الذنب، وتكون أعماله مطابقة لواقع الشريعة، فتكون ثورته المباركة هي العمل المناسب في ذلك الزمان، وهو العمل الشـرعي المطابق للواقع، ويكون تشخيص الإمام الحسين× لظروف تلك المرحلة هو التشخيص الدقيق الذي لا يشوبه أيّ خطأ، خصوصاً أنّ من وظائف الإمام× حفظ الشريعة الإسلامية من الضياع والانطماس، وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ما رأى أنّ الإسلام معرّض للخطر، كان عليه القيام بوظيفته على أحسن وجه، فهو أعرف بواقع مجتمعه، وأعرف بتكليفه من غيره، وأنّ عمله مصطبغ بالصبغة الشـرعية؛ لأنّه مطابق للواقع.
وقد أسلفنا فيما تقدّم أنّه من خلال وجوب اتّباع أهل البيت^، والقول بعصمتهم، يتّضح أنّ قيادة الأُمّة، وإقامة العدل فيها، وانصاف المظلوم، وردع الظالم، وإقامة الحدود والتعزيرات، وتشخيص القيام بالحروب أو الصلح، والفصل في القضاء، وغيرها ممّا يتعلّق بأُمور الحكم والسياسة، إنّما ذلك من وظائف الإمام×؛ لأنّه الوحيد الذي يكون تشخيصه للأحداث مطابقاً للواقع، وغير قابل للخطأ والاشتباه؛ لذا فإنّ ما يُطرح من بيان لوجوه شرعية هذه الثورة وفق نظرية النصّ إنّما هو محض تحليل وقراءة للإحداث، بهدف إيصال الصورة بطريقة واضحة للأجيال على مرّ العصور، أي أنّه تحليل لظروف تلك الثورة، وقراءة لاحقة لها بعد الإيمان مسبقاً بمشـروعيتها وحقّانيّتها في نفس الأمر والواقع.
نعم، على القول بعدم نظرية النصّ، كان من الضروري بيان وجوه الثورة، وهو ماتكفّله هذا الكتاب في أكثر مباحثه؛ ذلك لأنّ القارئ قد يكون من مدرسة لا تؤمن مسبقاً بالنص على الإمام، فضلاً عن عصمته.
كما أنّه وفق نظرية النص يتّضح جليّاً عدم مشروعية خلافة يزيد بن معاوية، وإنّه إنّما هو غاصب لمنصب إلهي ليس له، ولا نحتاج مع ذلك لإثبات فسق يزيد وعد علمه وعدم صحّة بيعته، فإنّ كلّ ذلك تنزّلاً وفق النظرية الأُخرى.
نصوص الإمامة وفق فهم المدرسة الأُخرى
من الواضح أنّ المبحث الآنف الذكر يتعلّق بمن يقول بنظرية النص، وأمّا على القول بعدم دلالة النصوص عليها كما عليه أهل السنّة، فهل يمكن القول بدلالتها على مشروعية الثورة أم لا؟
والجواب أنْ نقول: إنّه سيأتي في المبحث القادم النظر في بعض النصوص التي لا تدلّ على الإمامة صراحةً، لكنّه يمكن أنْ يُستفاد منها مشروعية الثورة الحسينية، وكذلك يمكن أنْ نقول أنّ النصوص المتقدّمة وغيرها التي لم نذكرها في هذا البحث المختصر تدلّ على مشـروعية الثورة أيضاً، وإنْ لم تدلّ على الإمامة بمعناها الأوسع، فلو تأمّلنا مثلاً في آية التطهير لوجدنا أنّها تعطي منقبة جليّة لأهل البيت^، وتبيّن أنّ هناك اهتماماً خاصّاً منقطع النظير في هذه المجموعة من البيت النبوي، بحيث حرص النبيّ’، وفي أكثر من مناسبة أنْ يغطّيهم ويجللهم بالكساء، ويرفض دخول غيرهم كأُمّ سلمة مثلاً، ويرفع يديه إلى السماء ويبيّن أنّ هؤلاء أهل بيته، ويدعو بإذهاب الرجس عنهم، ويتلو الآية الكريمة.
فهذه العناية الكريمة من النبيّ’ بمثابة الوصيّة للأُمّة في عظم شأن هؤلاء، وضرورة احترامهم وتبجيلهم، فكون النبيّ’ قدوة وأُسوة يفرض على الأُمّة الاعتناء بهذه الثلّة الخاصّة، ووجوب احترامهم وتقديرهم، ومع وجوب احترام هؤلاء وضرورة تقديرهم لا يمكن أنْ يصدر منهم فعلٌ يثير الفتنة في الأُمّة، ويفرّق شملها، وتكون عقوبته القتل والتنكيل، كما حصل ذلك في عاشوراء؛ لأنّ ذلك يتنافى مع أبسط مبادئ الاحترام والتقدير، فلا بدّ أنْ يكون النبيّ عالماً عارفاً بأنّ هذه الثلّة ومنها الحسين× لا يمكن أنْ تُقدم على أمر بهذه الخطورة، كخروج الحسين×، ورفضه لبيعة يزيد وما ترتّب على ذلك؛ لأنّ الخروج الحسيني إذا لم يكن مشروعاً كان جزاءه القتل، وهو يتنافى أشدّ المنافاة مع ضرورة التبجيل والاحترام والتقدير، فالتصرّف النبوي واعتناؤه المنقطع النظير بأهل البيت^ ومن ضمنهم الحسين^ يدلّك على مشـروعية الثورة الحسينية، وخطأ مخالفيه وقاتليه.
ولعلّ حديث الثقلين والسفينة أوضح من الآية دلالة على المطلوب؛ ذلك لأنّ الحديثين الشريفين إذا لم يدلّا على الإمامة، فلا أقلّ من دلالتهما على وصيّة النبيّ أُمّته في ضرورة احترام وتعظيم أهل البيت^، خصوصاً أنّ الحديث بصيغة لفظ مسلم أكّد على الوصية بهؤلاء، فجاء فيه: «أُذكّركم الله في أهل بيتي، أُذكّركم الله في أهل بيتي، أُذكّركم الله في أهل بيتي[447].
فهل هذه الوصيّة وهذا التأكيد يتناسب مع عدم شرعية خروج الحسين×، بل وهل يتناسب من النبيّ’ أنْ يورّط الأُمّة ويوصيها بأناس من الممكن أنْ يفرّقون شملها، ويكون حكمهم القتل.
من الواضح لكلّ مسلم ـ وبعيداً عن نظرية الإمامة ـ أنّه لا يمكن أنْ يصدر من هؤلاء هكذا خطأٌ فاحشٌ يتنافى في نتائجه مع وصية النبي’ في حقّهم؛ ولذا فإنّ الذي حصل هو خيانة بني أُميّة للنبي’، ومخالفته في وصيّته، وهذا ما أكّده الإمام القرطبي، حينما قال: «وبالجملة، فبنو أُميّة قابلوا وصية النبي (صلّى الله عليه وسلّم) في أهل بيته وأُمّته بالمخالفة والعقوق، فسفكوا دماءهم، وسبوا نساءهم، وأسروا صغارهم، وخرّبوا ديارهم، وجحدوا فضلهم وشرفهم، واستباحوا لعنهم وشتمهم، فخالفوا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) في وصيته، وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فوا خجلتهم إذا وقفوا بين يديه، ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه[448].
بل إنّ بعض علماء أهل السنّة وإنْ لم يروا إمامة أهل البيت^، إلّا أنّهم رأوا في حديث الثقلين والسفينة دلالة على وجوب اتّباعهم، والأخذ بأقوالهم وأفعالهم، فضلاً عن وجوب تعظيمهم، والمحافظة على حرمتهم:
قال الملا علي القاري ضمن تعليقه على حديث الثقلين: «والمُراد بالأخذ بهم التمسّك بمحبّتهم، ومحافظة حرمتهم والعمل بروايتهم، والاعتماد على مقالتهم...[449].
وقال السيد حسن السقّاف العالم السني المعاصر: «والمراد بالأخذ بآل البيت والتمسّك بهم هو محبّتهم، والمحافظة على حرمتهم، والتأدّب معهم، والاهتداء بهديهم وسيرتهم، والعمل برواياتهم، والاعتماد على رأيهم ومقالتهم واجتهادهم، وتقديمهم في ذلك على غيرهم[450].
وقال ابن حجر الهيتمي مبيّناً المراد من حديث السفينة: «ووجه تشبيههم بالسفينة... أنّ مَن أحبّهم وعظّمهم شكراً لنعمة مشـرّفهم، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات، ومَن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم، وهلك في مفاوز الطغيان[451].
وقال المناوي: «وجه التشبيه أنّ النجاة ثبتت لأهل السفينة من قوم نوح، فأثبت المصطفى (صلّى الله عليه وسلّم) لأُمّته بالتمسّك بأهل بيته النجاة، وجعلهم وصلة إليها، ومحصوله الحثّ على التعلّق بحبّهم وحبلهم وإعظامهم شكراً لنعمة مشرفهم، والأخذ بهدي علمائهم، فمَن أخذ بذلك نجا من ظلمات المخالفة، وأدّى شكر النعمة المترادفة، ومَن تخلّف عنه غرق في بحار الكفران، وتيار الطغيان، فاستحق النيران؛ لما أنّ بغضهم يوجب النار كما جاء في عدّة أخبار...[452].وذكر السمهودي في جواهر العقدين قريباً من ذلك[453].
وحيث إنّ الحسين× يمثّل أحد أعمدة أهل× البيت، سواء فسّرنا أهل البيت^ بالخمسة أصحاب الكساء، أو فسّرناه بعلمائهم كما يرى بعضهم ذلك[454]، فالحسين× من كبار علماء عصره بلا شكّ ولا نزاع، فمشروعية فعله ـ باعتبار وجوب الاعتماد على رأيه ومقالته، ولزوم الأخذ بهديه، وأنّ التخلّف عن ذلك يُوجب الغرق والضلال ـ بمستوى من الوضوح، بل يكون الحسين× وغيره من أهل البيت^ هم المعيار في معرفة الهدى والضلال.
المبحث الثاني
النصوص الدالّة على فضائله، ويمكن من خلالها الحكم على ثورته
وهذه النصوص عديدة جدّاً، نقتصر على نماذج منها فيما يلي:
أوّلاً: ما دلّ على أنّ الحسن والحسين÷ سيّدا شباب أهل الجنة.
ثانياً: ما دلّ على أنّ النبيّ’ حربٌ لمَن حاربهم، وسلمٌ لمَن سالمهم.
ثالثاً: ما دلّ على وجوب محبّة أهل البيت^، ومن ضمنهم الحسين×.
رابعاً: ما دلّ على أنّ مَن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهلية.
خامساً: ما دلّ على تأثر النبيّ وبكائه على الحسين×، وتأكيده على مظلوميته من قبل الأُمّة.
أوّلاً: ما دلّ على أنّ الحسن والحسين‘ سيّدا شباب أهل الجنة
ورد هذا الحديث بطرقٍ متكاثرة عن جمعٍ من الصحابة:
فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ’: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. أخرجه أحمد[455]، والترمذي[456]، والنسائي[457] وغيرهم. قال الترمذي: «هذا حديثٌ صحيح حسن[458]. ووافقه الألباني[459].
وعن حذيفة بن اليمان، قال: «سألتني أُمّي منذ متى عهدك بالنبي (صلّى الله عليه وسلّم)؟ قال: فقلتُ: منذ كذا وكذا. قال: فنالت منّي وسبّتني. قال: فقلتُ لها: دعيني فإنّي آتي النبي (صلّى الله عليه وسلّم) فأُصلّي معه المغرب، ثمّ لا أدعه حتّى يستغفر لي ولكِ. قال: فأتيت النبي (صلّى الله عليه وسلّم) فصلّيتُ معه المغرب، فصلّى النبي (صلّى الله عليه وسلّم) العشاء، ثمّ انفتل فتبعته، فعرض له عارض فناجاه، ثمّ ذهب فاتبعته، فسمع صوتي فقال: مَن هذا؟ فقلتُ: حذيفة. قال: ما لكَ؟ فحدّثته بالأمر، فقال: غفر الله لك ولأُمّك. ثمّ قال: أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال: قلتُ بلى قال: فهو ملك من الملائكة، لم يهبط الأرض قبل هذهِ الليلة، فاستأذن ربّه أنْ يُسلّم عليّ ويبشّرني أنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة، وأنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنّة. أخرجه أحمد[460] والترمذي وحسّنه[461]، وعقّب عليه الألباني قائلاً: «وهذا إسنادٌ صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح غير ميسرة ـ وهو ابن حبيب ـ وهو ثقة[462].
وعن ابن مسعود، قال: قال رسول الله’: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة، وأبوهما خير منهما. أخرجه الحاكم وقال: «هذا حديثٌ صحيح بهذهِ الزيادة، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي[463].
هذا، والحديث رواه جمعٌ آخر من الصحابة أيضاً، منهم: علي بن أبي طالب، و عمر بن الخطاب، و عبد الله بن عمر، و البراء بن عازب، و أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، و قرّة بن إياس، وغيرهم[464]. وله طرق متكثّرة؛ لذا قال السيوطي بتواتره[465]، وقال الألباني: «وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب، بل هو متواتر[466].
هذا من حيث السند والصحّة، وأمّا من حيث الدلالة، فالحديث يدلّ على أعلى درجات الفضل، وهي السيادة في الجنّة على مَن سواهما، باستثناء مَن خرّجه الخبر نفسه، وباستثناء النبيّ’؛ فهو خارج تخصّصاً وغير مشمول بالخبر، فهو المتكلّم والخبر غير ناظر إليه من الأساس.
وحينئذٍ نقول: إنّ التحرّك الحسيني يحتمل ثلاثة أُمور:
الأوّل: أنْ يكون تحرّكاً خاطئاً يحتوي على المفاسد من شقّ عصا المسلمين وإثارة الفتن بينهم، وعلى هذا الاحتمال لا يمكن أنْ يكون الحسين× سيّد شباب أهل الجنّة، إذ كيف يُوصف مفرّق الصفوف ومُثير الفتن بأنّه سيّد شباب أهل الجنّة، فإنّه مستحقّ للقتل حينئذٍ، والنار به أولى، وإذا تنزّلنا وحصلت له المغفرة الإلهية فسيكون في الجنّة وليس سيّدها، فهذا الاحتمال لا يمكن أنْ ينسجم مع الحديث الشريف المتواتر.
الثاني: أنْ يكون الحسين× قد اجتهد في هذه المسألة، لكنّ اجتهاده لم يكن مصيباً للواقع، بل كان مخطئاً في ذلك، وهذا الاحتمال كسابقه لا يُوجب له أنْ يكون سيّد شباب أهل الجنّة؛ لأنّه وبسبب اجتهاده الخاطئ قتل الكثير من الفريقين، وأُيتمت الأطفال... فغاية ما يمكن قوله أنّ له أجراً، وهذا لا يُوجب له أنْ يكون سيد شباب أهل الجنّة.
الثالث: أنْ يكون تحرّكه عين الصواب، وهو التكليف المناسب لتلك المرحلة؛ لما فيه من حفظ للإسلام من الضياع، وقمع للبدعة التي أخذت بالانتشار.
وهذا الاحتمال ينسجم مع الحديث الشـريف، فإنّ التحرّك بهذه الكيفية المصيبة دفاعاً عن الدين والرسالة المحمدية، ويُقتل على هذا الطريق من الممكن أنْ يكون سيّد شباب أهل الجنّة.
وحيث إنّ الاحتمالين الأولين غير صحيحين، ولا ينسجمان مع الحديث، فيتيعيّن الاحتمال الثالث، وهو أنّ الثورة الحسينية ثورة مشـروعة بكل المقاييس؛ ولذا استحقّ قائدها أنْ يكلّل بهذه الفضيلة والمنقبة، ويكون سيّد شباب أهل الجنّة.
ثانياً: ما دلّ على أنّ النبيّ’ حرب لمَن حارب أهل البيت^، وسلمٌ لمَن سالمهم
أخرج أحمد بسنده إلى أبي هريرة، قال: «نظر النبي (صلّى الله عليه وسلّم) إلى عليّ والحسن والحسين وفاطمة، فقال: أنا حربٌ لمَن حاربكم وسلمٌ لمَن سالمكم[467].
وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم: «إنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال لعليّ وفاطمة وحسن وحسين^: أنا حربٌ لمَن حاربكم، سلمٌ لمَن سالمكم[468].
وأخرجه الترمذي والحاكم بلفظ: «أنا حربٌ لَمن حاربتم، وسلمٌ لمَن سالمتم[469].
وهو من الأحاديث المعتبرة عند أهل الفن، فقد أخرجه الحاكم من طريق أبي هريرة، وقال: «هذا حديث حسن.... وذكر له شاهداً، وهو حديث زيد بن أرقم المتقدّم، ووافقه الذهبي في التلخيص على ذلك؛ إذ سكت عن تحسينه للحديث، وذكر حديث زيد بن أرقم بعنوان شاهد له أيضاً[470]، كما أخرج الحديث ابن حبان في صحيحه[471]، ومعلوم من مقدّمة ابن حبّان في كتابه أنّه لا يخرّج إلّا الصحيح.
ولا يشكّ أحدٌ بأنّ الحديث يدلّ صراحةً على عظم مقام أبناء هذا البيت، وعلوّ درجاتهم؛ بحيث صار المحارب لهم محارباً لرسول الله’. ومعلومٌ أنّ المحارب لرسول الله’ إنّما هو محاربٌ للإسلام المحمّدي، ومحاربٌ لله (عزّ وجلّ).
فالرسول، إذن، جعلهم مداراً ومعياراً يُعرف من خلاله مَن حارب الإسلام ومَن يكون معه في سلم، ومنه يتّضح أنّ يزيد وجيشه كانوا على الباطل، وأنّ التحرّك الحسيني كان تحرّكاً مشـروعاً؛ لأنّ قتال يزيد للإمام الحسين× يعدّ حرباً وقتالاً للنبيّ’، وهو حربٌ وقتالٌ للإسلام.
ثالثاً: ما دلّ على وجوب محبّة أهل البيت^ ومن ضمنهم الحسين×
من الثابت عند الفريقين أنّ وجوب محبّة أهل البيت^ هي ضرورة إسلامية، إنّما الخلاف وقع في إمامتهم ولم يناقش أو يشكّك أحد في وجوب محبّتهم سلام الله عليهم؛ قال ابن تيمية: «ومن أُصول أهل السنّة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)... ويحبّون أهل بيت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، ويتولّونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، حيث قال يوم غدير خمّ: أذكّركم الله في أهل بيتي، أذكّركم الله في أهل بيتي. وقال أيضاً للعباس عمّه ـ وقد اشتكى إليه أنّ بعض قريش يجفو بني هاشم ـ فقال: والذي نفسـي بيده، لا يؤمنون حتى يحبّوكم لله ولقرابتي. وقال: إنّ الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم[472].
وقال الفخر الرازي: «لا شكّ أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) كان يحبّ فاطمة÷، قال (صلّى الله عليه وسلّم): فاطمة بضعةٌ منّي يؤذيني ما يؤذيها. وثبت بالنقل المتواتر أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) كان يحبّ علياً والحسن والحسين، وإذا ثبت ذلك وجب على كلّ الأُمّة مثله؛ لقوله: (وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ). ولقوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ) . ولقوله: (إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ). ولقوله سبحانه وتعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) .
[وأضاف:] إنّ الدعاء للآل منصبٌ عظيم، ولذلك جُعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، وهو قوله: اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد، وارحم محمّداً وآل محمّد، وهذا التعظيم لم يوجد في حقّ غير الآل، فكلّ ذلك يدلّ على أنّ حبّ آل محمّد واجب، وقال الشافعي (رضي الله عنه):
يا
راكباً قف بالمحصب من منى |
و
اهتف بساكن خِيفها والناهض |
|
سحراً
إذا فاض الحجيج إلى منى |
فيضاً
كما نظم الفرات الفائض |
|
إنْ
كان رفضاً حبُّ آل محمّد |
فليشهد
الثقلان أنّي رافضـي[473]. |
لذا لا نرى ضرورة للخوض في ذكر الأدلّة على وجوب حبّ أهل البيت^، ونقتصر ـ من باب التيمن والتبرك ـ على ذكر بعض الروايات الدالّة على وجوب الحبّ، وقد ورد فيها اسم الإمام الحسين×:
1ـ عن عبد الله بن مسعود، قال: «كان النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) يصلّي والحسن والحسين يثِبان على ظهره، فيباعدهما الناس، فقال (صلّى الله عليه وسلّم): دعوهما، بأبي هما وأُمّي، مَن أحبّني فليحبّ هذين. أخرجه النسائي[474]، وابن أبي شيبة[475]، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما[476]، وأورده ابن حجر في الإصابة[477]، واللفظ لابن حبان. قال ابن حجر بعد ذكر الحديث: «وله شاهدٌ في السنن، وصحيح ابن خزيمة، عن بريدة، وفي معجم البغوي نحوه بسندٍ صحيح، عن شداد بن الهاد[478]. وقال الألباني: «حَسَن[479].
وقد عرفت أنّه صحيح عند ابن حبّان، وابن خزيمة أيضاً؛ لوجوده في كتابيهما، وقد التزما بذكر ما هو صحيح فقط، كما هو جليٌّ واضح من مقدّمة كتابيهما.
2ـ وعن أبي هريرة، قال: «سمعتُ رسول الله يقول للحسن والحسين: مَن أحبَّني فليحِبَّهما.
أخرجه أبو داود الطيالسي[480]، بلفظ: «فليحبَّ هذين. والبزّار في (مسنده) على ما في (مجمع الزوائد)،قال الهيثمي: «رواه البزّار، ورجاله وُثّقوا، وفيهم خلاف[481].
قلتُ: عرفتَ أنّ الحديث الأول حَسَن، فيكون هذا الحديث على فرض ضعفه، شاهداً للأوّل.
3ـ وعن ابن مسعود أيضاً: «أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال للحسن والحسين: اللهمّ إنّي أُحبّهما فأحبّهما، ومَن أحبّهما فقد أحبّني. قال الهيثمي: «رواه البزار وإسناده جيد[482].
4ـ وعن أبي هريرة قال: «خرج علينا رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) ومعه الحسن والحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرّة وهذا مرّة حتّى انتهى إلينا، فقال له رجل: يا رسول الله، إنّك تحبّهما؟ فقال: نعم، مَن أحبَّهما فقد أحبَّني، ومَن أبغضهما فقد أبغضني. أخرجه الحاكم[483]، وأحمد[484]، وغيرهم. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي[485].
وأخرج الحديث جماعة من المحدّثين، عن أبي هريرة مختصراً، مُقتصـرين فيه على قوله فيهما: «مَنْ أحبَّهما فقد أحبَّني، ومَن أبغضهما فقد أبغضني. أخرجه النسائي[486]، وأحمد[487]، والطبراني[488]، وغيرهم. قال العلامة أحمد محمّد شاكر: «إسناده صحيح[489].
وفي الباب روايات عديدة جدّاً.
فإذا كان النبيّ’ يحبّ الحسين× ويأمر الأُمّة بحبّه، بل ويصـرّح بأنّ مبغض الحسين× هو مبغضٌ له، فكيف يمكن أنْ نتصوّر أنّ الحسين× خارجٌ على خليفة زمانه، وشاقٌّ لعصا المسلمين ويجب قتله، فكيف ينسجم وجوب القتل مع وجوب الحبّ، فهذه المسألة الضرورية وهي وجوب حبّ الحسين× وبقية أهل البيت^، تدلّ بصورة واضحة أنّ حركة الحسين× حركة مشروعة، وأنّ مَن قاتل وقتل الحسين× ومَن أمر بذلك إنّما هو مبغض للحسين× و للرسول’، وإلّا فيلزم من ذلك اجتماع النقيضين على الأُمّة، فهي من جهة يجب عليها حبّ الحسين×، ومن جهة يجب عليها قتل الحسين×! وهذا واضح البطلان، والحقيقة أنّ كلّ مسلم لو خُلّي وطبعه، وتأمّل بفطرته، بعيداً عن التشويش الذهني؛ لرأى أنّ وجوب حبّ الحسين× وحبّ النبي’ له، وطريقته في بيان فضله تدلّ بلا شكّ على مشـروعية ثورته، وحقّانية موقفه، خصوصاً حينما يتأمّل في الحديث الذي أشرنا إليه سابقاً، وهو قول النبيّ’: «حسين منّي وأنا من حسين، أحبّ الله مَن أحبّ حسيناً[490]، لآمن واطمأنّ قلبه بأنّ ثورة الحسين× هي امتداد لمشروع النبيّ’ الرسالي في هذه الأُمّة، فالنبيّ’ جاء بالرسالة، والحسين× عمل على تثبيت تلك الرسالة في حقبة أُريد فيها للإسلام أنْ يُطمس ويُغيَّب.
رابعاً: ما دلّ على أنّ مَن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهلية
وهذا الحديث صحيحٌ متّفق عليه بين الفريقين، فقد رواه الكليني من محدّثي الشيعة بلفظ: «مَن مات لا يعرف إمامه مات ميتةً جاهلية[491]. ولهم فيه طرق عديدة، وألفاظ متقاربة، لا نرى ضرورة للخوض بها.
وما يهمّنا أنْ نقف على هذا الحديث في كتب أهل السنّة، ومن الواضح أنّهم رووه بألفاظ قريبة من ذلك، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عمر، قال: «سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول: ...ومَن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتةً جاهلية[492].
وعن أبي هريرة ومعاوية، أنّ النبيّ قال: «مَن مات وليس عليه إمام، مات ميتةً جاهلية. قال الألباني: «إسناده حسن[493].
وعن عبد الله بن عمر، قال: «سمعت رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) يقول: مَن مات بغير إمام مات ميتة جاهلية[494].
والروايات عديدة في ذلك، ووجه الاستدلال بها أنّ الحسين× يعدّ من الصحابة عند أهل السنّة، والصحابة من أهل الجنّة، والحسين× لم يبايع لا ليزيد ولا لغيره. فيكون أمره بين اثنين، إمّا أنْ يكون هو الإمام ويزيد هو المنحرف الباغي المتسلّط على المسلمين بغير وجه، ولا تجب بيعته، ويجوز الخروج عليه، أو يكون يزيد هو الإمام، وإنّ الإمام الحسين× هو الباغي الشاقّ لعصا المسلمين، والمفرّق لشملهم ويجب قتله.
فإنْ كان الثاني، أي أنّ يزيد هو الخليفة الشرعي؛ لزم أنْ يكون الحسين× مات ميتة جاهلية، فيكون في النار نستجير بالله؛ لأنّ الجاهلية إمّا أنْ تكون جاهلية الكفر، أو جاهلية النفاق والضلال، وكلاهما يوجبان النار، في حين أنّ الحسين× من الصحابة، والصحابة من أهل الجنّة، فضلاً عن الحديث المتقدّم في حقّه، بأنّه وأخيه الحسن÷ سيدا شباب أهل الجنّة، فلابدّ حينئذٍ من المصير إلى القول بأنّ يزيد لم يكن خليفة شرعيّاً، ولا تجب بيعته ولا طاعته، بل يجب الخروج عليه؛ لاغتصابه كرسي الخلافة، وعدم حكمه بما أنزل الله، وهذا يعني مشروعيّة الثورة الحسينية.
وما يُقال من أنّ الحسين× طلب أنْ يضع يده بيد يزيد، لكن القوم رفضوا ذلك، فلا ينطبق عليه أنّه لم يبايع، فهذا غير صحيح، وهو محض تهرّب من الجريمة، وتلميع لصورة يزيد لا أكثر؛ لأنّ هذا يتنافى مع موقف الإمام الحسين× من عدم البيعة، واضطراره الخروج إلى مكّة، وثمّ التعجيل بالخروج من مكّة خوف القتل، وتصريحاته المتكرّرة بأنّ يزيد فاسق شارب للخمر «ومثلي لا يبايع مثله، وأنّه: «على الإسلام السلام؛ إذ قد بُليت الأُمّة براعٍ مثل يزيد، وتصريحاته المتكرّرة بأنّ القوم تركوا طاعة الرحمن، ولزموا طاعة الشيطان، وأنّ السنّة أُميتت والبدعة أُحييت، وغير ذلك الكثير من الخطب منذ كان بالمدينة وإلى حين يوم عاشوراء، وكلّها تتنافى مع أنّه أراد أن يضع يده بيد يزيد.
أضِف إلى ذلك، فإنّ عقبة بن سمعان وهو ممَّن صحب الحسين×، قد أنكر وكذّب هذا الخبر، فقال: «صحبت حسيناً، فخرجت معه من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، ولم أُفارقه حتّى قُتل، وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة، ولا بمكة، ولا في الطريق، ولا بالعراق، ولا في عسكر، إلى يوم مقتله إلّا وقد سمعتها، ألا والله ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون من أن يضع يده في يد يزيد بن معاوية، ولا أن يسيّروه إلى ثغرٍ من ثغور المسلمين، ولكنّه قال: دعوني فلأذهب في هذه الأرض العريضة، حتّى ننظر ما يصير أمر الناس[495].
خامساً: ما دلّ على تأثّر النبيّ وبكائه على الحسين وتأكيده على مظلوميته×
والروايات في هذا الباب عديدة جدّاً، لا يسعنا هنا إلّا أن نقف على نماذج منها؛ تلبية للغرض، وإلّا فهي تحتاج إلى بحوث موسّعة، وبطبيعة الحال سنقتصـر في النقل على رواه أهل السنّة، ومن هذه الروايات:
1ـ أخرج أحمد والحاكم وغيرهم ـ واللفظ لأحمد ـ عن عمّار بن عمّار، عن ابن عبّاس، أنّه قال: «رأيتُ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) في المنام بنصف النهار أشعث أغبر، معه قارورة فيها دم يلتقطه أو يتتبّع فيها شيئاً، قال: قلت: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: دم الحسين وأصحابه، لم أزل أتتبّعه منذ اليوم. قال عمّار: فحفظنا ذلك اليوم، فوجدناه قُتل ذلك اليوم[496]. وهذا الحديث صحّحه الحاكم وكذلك الذهبي[497].
ومن الواضح أنّ هذا الحديث طبق ما يتمناه أهل السنّة ـ من أنّ رؤية النبيّ’ هي رؤية صادقة، وأنّ الشيطان لا يتمثّل به[498] ـ يوضح اهتماماً خاصّاً من النبيّ’ في قضيّة الحسين×، وكان يخبر الأُمّة عن ذلك، وكان في غاية التأثّر والحزن (أشعث أغبر)، وكان يجمع ويلتقط دم الحسين× وأصحابه، وهذا يدلّل على أنّ النبيّ’ كان يرى مشـروعية الثورة وحقّانيتها، وإلّا لا داعي أنْ يكون أشعث أغبر على شخص خارج بغير وجه حقٍّ على إمامه، ومفرّق لشمل الأُمّة، والنبيّ’ لا تأخذه في الله لومة لائم، فهذا العمل منه يشير صراحةً إلى مظلومية الحسين× وأصحابه، وأنّهم كانوا على الحقّ، خصوصاً أنّ النبي’ لم يقتصر في التقاط الدم على دم الحسين×، بل دم الحسين وأصحابه، فلا يمكن تصوير الأمر بالعاطفة والقرابة وما شاكل ذلك، مع أنّنا نرى أنّ الرسول’ لا يمكن أن يتصـرّف وفق العاطفة، إلّا فيما تتوافق مع الشرع الحنيف.
2ـ أخرج أحمد عن عبد الله بن نجيّ عن أبيه، قال: «إنّه سار مع عليّ (رضي الله عنه) وكان صاحب مطهّرته، فلمّا حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفّين، فنادى علي (رضي الله عنه): اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت: وماذا؟ قال: دخلت على النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبيّ الله، أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال: بل قام من عندي جبريل قبل، فحدّثني أنّ الحسين يُقتل بشطّ الفرات. قال: فقال: هل لك إلى أنْ أشمّك من تربته؟ قال: قلت: نعم. فمدّ يده فقبض قبضةً من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أنْ فاضتا[499]. قال الهيثمي: «رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار، والطبراني ورجاله ثقات، ولم ينفرد نجيّ بهذا[500].
ففي هذا الخبر نلاحظ أنّ الإمام عليّاً ينادي صبراً أبا عبد الله، وهي دلالة على ما يحلّ به من الظلم والجور، وإلّا كيف يُنادى مَن هو شاقٌّ لعصا المسلمين ومفرّق الأمّة بالصبر، ونلاحظ أنّ النبيّ’ يبكي وعيناه تفيضان بالدموع، وأنّ جبرئيل نزل من السماء ليخبر النبيّ بهذه الفاجعة ويحكي له الخبر، بل ويلتقط قبضةً من تراب كربلاء ليشمّها النبيّ’، والنبيّ لا يتمالك عيناه، فلماذا كلّ هذا؟ أهي من أجل شخص سيُفرّق الأُمّة ويموت وهو عاصٍ خارج على الجماعة؟ أم هي بيان لعظمة الحسين× وعظمة ثورته ومظلوميته الكبرى، وحقانيته ومشروعية تحرّكه المبارك، لا نشكّ في أنّ المسلم المتّبع للنبيّ’، المُقتدي والمتأسّي بسيرته، سيجزم بالثاني، ويعرف من خلال تصـرّفات النبيّ’ قيمة هذه الثورة، ومدى انحراف الأُمّة التي تجرّأت وقتلت ابن بنت نبيّها!
3ـ وعن عائشة أو أُمّ سلمة: «أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم) قال لإحداهما: لقد دخل عليّ البيت ملك فلم يدخل عليّ قبلها، قال: إنّ ابنك هذا حسين مقتول، وإنْ شئت أريتك من تربة الأرض التي يُقتل بها. قال: فأخرج تربة حمراء[501]. قال الذهبي: «إسناده صحيح[502]. وقال الهيثمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح[503].
وهذا الخبر أيضاً كغيره يبيّن اهتمام السماء بسمألة عاشوراء، فيدخل ملكٌ لبيت النبيّ’ لم يسبق له الدخول، لا لشـيء سوى أنْ يخبره بمقتل ولده الحسين×، ويريه تربة حمراء من الأرض التي قُتل فيها، وما هذا الاهتمام إلّا نوعاً من إيقاظ الأُمّة وتنبيهها إلى مظلومية الحسين× ومشروعية ثورته، وهي رسالة غيب إلى جميع الأُمّة بأنّ ثورة الحسين× ثورة مشـروعة، وأنّه سيُقتل مظلوماً، فإنّ السماء سبقت الحدث لتخبر عنه، ولتُخرس الألسن التي تحاول التشكيك في مشروعية تلك الثورة، فكيف يتصوّر المسلم أنّ الملك ينزل من السماء، ويُري النبيّ’ تربة حمراء لمجرد أنّ الحسين× شخص خارج على الجماعة، ومستحقّ للقتل! ولماذا يخبر النبيّ’ غيره بهذه القصّة؟
من الواضح أنّ النبيّ’ أراد أنْ يوصل هذا الخبر لأسماع الأُمّة؛ ليعرفوا أنّ مسألة الحسين× هي مسألة السماء، تدخّلت فيها الملائكة، وجاءت لتبيّن هذا الخبر المفجع بأنّ الأُمّة ستنحرف، وستقتل ابن نبيّها، وتحاول بعد ذلك التضليل وحرف الحقائق.
4ـ عن أُمّ سلمة: «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) اضطجع ذات يوم فاستيقظ وهو خاثر، ثمّ اضطجع، ثمّ استيقظ وهو خاثر دون المرّة الأُولى، ثمّ رقد ثمّ استيقظ وفي يده تربة حمراء، وهو يُقلّبها[504]، فقلت: ما هذه التربة؟ قال: أخبرني جبريل أنّ الحسين يُقتل بأرض العراق، وهذه تربتها[505].
وهذا الخبر أخرجه الطبراني بلفظٍ قريب من ذلك، عن إبراهيم بن دحيم، حدثنا موسى بن يعقوب، حدّثني هاشم بن هاشم، عن وهب بن عبد الله بن زمعة، قال: أخبرتني أُمّ سلمة، وساق الخبر.
وكذلك عن عبد الله بن الجارود النيسابوري، ثنا أحمد بن حفص، حدّثني أبي، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبّاد بن إسحاق، عن هاشم بن هاشم، عن عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أُمّ سلمة[506]. وهذا السند صحيح كما سيأتي.
وأخرجه الحاكم عن أُمّ سلمة باختلافٍ يسيرٍ في الألفاظ، فقد جاء فيه: «أنّ رسول الله’ اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر، ثمّ اضطجع فرقد ثمّ استيقظ وهو حائر دون ما رأيت به المرّة الأُولى، ثمّ اضطجع فاستيقظ وفي يده تربة حمراء يُقبّلها، فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: أخبرني جبريل(عليه الصلاة والسلام) أنّ هذا يقتل بأرض العراق ـ للحسين ـ فقلت لجبريل: أرِني تربة الأرض التي يُقتل بها. فهذه تربتها. قال الحاكم: «هذ حديثٌ صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصحّحه الذهبي على شرط الشيخين أيضاً[507].
وفي هذا الخبر نرى حزن النبيّ’ وبكاءه وانزعاجه لمقتل ولده الحسين×، ونرى أنّه يستيقظ أكثر من مرّة على غير طبعه متأثّراً قلقاً منزعجاً ممّا يراه، بل إنّه استيقظ في المرّة الأخيرة وبيده تلك التربة الحمراء التي اصطبغت بدم الحسين× الطاهر وهو يُقبّلها (أو يقلّبها)، فهل هذا الفعل من النبيّ’ ينسجم مع عدم مشروعية ثورته، وهل يدلّ على صحّة عمل يزيد وفرقته، أو يدلّ على عكس ذلك تماماً، من الواضح أنّ كلّ مسلم لو يرى النبيّ’ وبكاءه وانزعاجه وانفعاله على ما رآه من مقتل الحسين× لجزم واطمئنّ بأنّ موقف الحسين× هو الموقف الشـرعي، وأنّ يزيد وأتباعه هم الجُناة والبغاة.
هذه فقط نماذج من الروايات التي تتحدّث عن إخبار النبيّ’ وحزنه الشديد على ولده الحسين×، وهي كما عرفنا رسالة للأُمّة تبيّن مشروعية تحرّك الحسين× ومظلوميته، وانحراف الأُمّة التي قتلته.
اتّضح من خلال هذا الفصل أنّه يمكن أنْ نحكم على مشـروعية الثورة الحسينية بعيداً عن أجواء وظروف ذلك المجتمع؛ ذلك بأنّ نفس الروايات النبوية تدلّل أنّ العمل الحسيني لا بدّ أنْ يكون مشروعاً، وقد قسّمنا الفصل إلى مبحثين، تناول الأوّل ما دلّ على إمامة الحسين× من النصوص الشـرعية، وقلنا: إنّه بناءً على تمامية تلك النصوص على إمامة الحسين× ستكون مشروعية تحرّكه بمستوى من الوضوح؛ إذ يُعتبر هو الإمام المُفترض الطاعة على كافّة الأُمّة، بل أوضحنا أنّه حتى عند مَن لم تتمّ له النصوص على الإمامة فهي تدلّ على لزوم توقير وحفظ واحترام أهل البيت^، بل والـتأسّي بهم، والاعتماد على مقالهم وأفعالهم، ومعه يكون التحرّك الحسيني مشروعاً أيضاً؛ إذ لا يمكن اجتماع وجوب الحفاظ عليهم واحترامهم مع كون تحرّكهم مخالفاً للشريعة، ويستحقّون عليه القتل!
ثمّ تناولنا في المبحث الثاني عدّة من الروايات التي لا تدلّ على الإمامة، لكن يمكن أنْ نستفيد منها مشروعية الثورة؛ لمنافاة دلالاتها مع عدم المشروعية.
وبهذا نختم هذا الكتاب؛ عسى أنْ نكون وُفّقنا فيه لبيان جانب من الحقيقة، وبيان أنّ الثورة الحسينية ثورة مشروعة، ليس على المستوى الشرعي فحسب، بل أنّها يمكن أنْ تؤطّر ضمن القوانين التي جاءت بعدها بسنين طويلة؛ لأنّها ثورة انبثقت من الفطرة، ونادى بها الضمير الإنساني.
وآخر دعوانا أنْ الحمد لله ربّ العالمين
القرآن الكريم
(أ)
1. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـرة، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي، بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، الناشر دار الوطن للنشـر، الرياض، ط1، 1420هـ/1999م.
2. أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصّاص، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ/1994م.
3. الأحكام السلطانيّة، أبو يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء، صحّحه وعلّق عليه محمّد حامد الفقي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1421هـ/2000م.
4. الأحكام السلطانية والولايات الدينية، علي بن محمّد الماوردي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، 1405هـ/1985م.
5. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشـي)، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق السيد مهدي الرجائي، تصحيح وتعليق مير داماد الاسترابادي، الناشر مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، طبعة عام 1404هـ.
6. الأخبار الطوال، أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري، الناشر دار إحياء الكتاب العربي، تحقيق عبد المنعم عامر، مراجعة الدكتور جمال الدين الشيال، ط1، 1960م.
7. الأخبارالموفقيّات، الزبير بن بكار، تحقيق د. سامي مكي العاني، الناشر عالم الكتب، ط2، 1416هـ/1996م.
8. الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أُصول الاعتقاد، أمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني، حقّقه وعلّق عليه وقدّم له وفهرسه د. محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد الحميد، الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة عام 1369هـ.
9. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد العكبري البغدادي،، تحقيق مؤسّسة آل البيت^ لتحقيق التراث، الناشر دار المفيد، بيروت، ط2، 1414هـ.
10.الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البرّ، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ.
11.استجلاب ارتقاء الغرف بحبّ أقرباء الرسول وذوي الشـرف، شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق خالد بن أحمد الصمّي، دار البشائر، بيروت، طبعة عام1421هـ.
12.أُسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجزري، تحقيق عادل أحمد الرفاعي، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، ط1، 1417 هـ/1996م.
13.الإصابة في تمييز الصحابة، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، الناشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، ط1ـ 1415هـ/1995م.
14.أُصول الدعوة، عبد الكريم زيدان، ط3، 1396هـ/1976م.
15.الاعتصام، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
16.الإمامة والسياسة، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق طه محمد الزيني، الناشر مؤسّسة الحلبي.
17.الأمالي، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة، الناشر مركز الطباعة والنشـر في مؤسّسة البعثة، ط1، 1417هـ.
18.الأمالي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة، الناشر دار الثقافة، قم، ط1، 1414هـ.
19.الإمام الحسين، عبد الله العلايلي، الناشر دار التربية، بيروت ـ لبنان، 1972م.
20.أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري، تحقيق د. سهيل زكّار، ود. رياض زركلي، الناشر دار الفكر، بيروت، ط1، 1417هـ.
(ب)
21.البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، تحقيق وتدقيق وتعليق علي شيري، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1408هـ.
22.البدء والتاريخ، مطهر بن طاهر المقدسي، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد.
(ت)
23.تاريخ الأُمم والملوك، محمد بن جرير الطبري، مراجعة وتصحيح وضبط نخبة من العلماء، الناشر مؤسّسة الأعلمي، بيروت، ط4، 1403هـ.
24.تاريخ المدينة، أبو زيد عمر بن شبه النميري، تحقيق فهيم محمد شلتوت، الناشر دار الفكر، قم، طبعة عام 1410هـ.
25.تاريخ مدينة دمشق، علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر، تحقيق علي شيري، الناشر دار الفكر، بيروت، 1415هـ/1995م.
26.تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هـ.
27.تاريخ الإسلام، شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق د. عمر عبد السلام تدمري، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1407هـ.
28.تاريخ الخلفاء، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: مطبعة السعادة، مصـر، ط1، 1371هـ.
29.تاريخ اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب اليعقوبي، الناشر دار صادر، بيروت.
30.تعجيل المنفعة، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان.
31.التذكرة الحمدونية، محمّد بن الحسن ابن حمدون، تحقيق إحسان عبّاس وبكر عبّاس، الناشر دار صادر، بيروت ـ لبنان، ط1، 1996م.
32.تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق أبو قتيبة نظر الفاريابي، مكتبة الكوثر، الرياض، ط2، 1415هـ.
33.تذكرة الخواص، يوسف بن فرغلي سبط بن الجوزي، تحقيق د. عامر النجار، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، ط1، 1429هـ/2008م.
34.التفسير الكبير، محمد بن عمر الرازي، ط3.
35.تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم)، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق أسعد محمد خطيب، الناشر المكتبة العصرية ـ صيدا.
36.تذكرة الفقهاء، العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي، تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط1، 1414هـ.
37.تاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن خياط العصفري، تحقيق د. سهيل زكّار، الناشر دار الفكر، بيروت، 1993م ـ 1414هـ.
38.تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق إبراهيم أبو طفيش، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة عام 1405هـ.
39.التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق د. الصادق بن محمد بن إبراهيم، الناشر مكتبة دار المنهاج، الرياض، ط1، 1425هـ.
40.تهذيب خصائص الإمام علي×، أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق محمد ابن شريف أبو إسحاق الحجازي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1405هـ.
(ج)
41.جامع الأُصول في أحاديث الرسول|، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، الناشر مكتبة الحلواني، ومطبعة الملاح، ومكتبة دار البيان، طبعة عام1392هـ/1972م.
42.جوامع السيرة، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، تحقيق الدكتور إحسان عباس، والدكتور ناصر الدين الأسد، ومراجعة أحمد محمد شاكر، الناشر دار المعارف، مصر.
43.جواهر العقدين، عليّ بن أحمد بن عبد الله السمهودي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ.
44.الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، محمّد بن أبي بكر الأنصاري البري، تحقيق د. محمّد التونجي، الناشر مكتبة النووي، دمشق، ط1، 1402هـ.
(خ)
45.الخرائج والجرائح، سعيد بن هبة الله قطب الدين الراوندي، تحقيق ونشر مؤسّسة الإمام المهدي#، ط1، 1409هـ.
46.الخلافة، محمّد رشيد رضا، الناشر: الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر.
(ر)
47.روضة الطالبيين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
48.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي البغدادي، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت.
49.الرياض النضرة في مناقب العشرة، أبو جعفر محبّ الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
(ز)
50.زاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، تحقيق محمد عبد الرحمن عبد الله، الناشر دار الفكر، بيروت، ط1، 1407هـ.
51.الزهرة العطرة في حديث العترة، أبو المنذر سامي بن أنور المصري الشافعي، الناشر دار الفقيه، مصر، طبعة عام1969م.
(س)
52.سبل الهدى والرشاد في سيرة خيرة العباد، محمّد بن يوسف الصالحي الشامي، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1414هـ.
53.السقيفة وفدك، أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، رواية عزّ الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي، تقديم وجمع وتحقيق الدكتور الشيخ محمّد هادي الأميني، الناشر شركة الكتبي للطباعة والنشـر، بيروت ـ لبنان، ط2، 1413هـ.
54.السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ.
55.سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، الناشر دار الفكر، بيروت، ط1، 1348هـ/1930م.
56.سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني، تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام، الناشر دار الفكر، بيروت، ط1، 1410هـ.
57.سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، الناشر مكتبة المعارف، الرياض، طبعة عام 1415هـ.
58.سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف، وعبد الرحمن محمد عثمان، الناشر دار الفكر، بيروت، ط2، 1403هـ/1983م.
59.السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، علي بن برهان الدين الحلبي، الناشر دار المعرفة، طبعة عام 1400هـ.
60.سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي، أشرف على تحقيق الكتاب وخرّج أحاديثه شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط9، 1413هـ.
(ش)
61.شرح نهج البلاغة، عزّ الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المعتزلي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر دار إحياء الكتب العربية، ط1، 1378هـ.
62.الشـريعة، أبو بكر محمّد بن الحسين الآجري، تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الرياض، ط2، 1420هـ.
63.شرح المقاصد في علم الكلام، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، الناشر دار المعارف النعمانية، باكستان، ط1، 1401هـ.
64.شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، عبد الله بن أحمد الحسكاني، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، الناشر مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إيران، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، ط1، 1411هـ.
65.شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، القاضي النعمان أبو حنيفة بن محمد بن منصور المغربي، تحقيق السيد محمد الحسيني الجلالي، الناشر جماعة المدرّسين، قم، ط2، 1414هـ.
66.شرح نهج البلاغة، محمد عبده، الناشر: دار الذخائر، قم، ط1، 1412هـ.
67.شرح صحيح مسلم (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة عام 1407هـ.
68.شعراء النصـرانية بعد الإسلام، لويس شيخو اليسوعي، الناشر مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين، بيروت، 1890م.
(ص)
69.الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الناشر دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1407هـ.
70.صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبّان التميمي البستي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الناشر مؤسّسة الرسالة، ط2، 1414هـ.
71.صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، تحقيق وتعليق وتخريج وتقديم الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الناشر المكتب الإسلامي، ط2، 1412هـ.
72.صحيح شرح العقيدة الطحاوية، حسن بن علي السقاف، الناشر دار الإمام النووي، الأردن، ط1، 1416هـ.
73.صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، محمّد ناصر الدين الألباني، الناشر دار الصميعي، ط1، 1422هـ.
74.صلح الحسن، الشيخ راضي آل ياسين، خال من البيانات.
75.صحيح البخاري (الجامع المسند الصحيح)، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الناشر دار الفكر، بيروت، طبعة عام 1401هـ.
76.صحيح مسلم (الجامع الصحيح)، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، الناشر دار الفكر، بيروت.
77.الصواعق المحرقة، الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن حجر المكي، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله التركي، كامل محمد الخراط، الناشر مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط1، 1417هـ.
(ط)
78.الطبقات الكبرى، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع، الناشر دار صادر، بيروت.
(ع)
79.العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل، محمد بن عقيل بن عبد الله العلوي الحضـرمي، تحقيق وتعليق: حسن بن علي السقاف، الناشر دار الإمام النووي، عمان، ط1، 1425هـ.
80.علل الشرائع، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق القمي، تقديم السيد محمد صادق بحر العلوم، الناشر منشورات المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، طبعة عام1385هـ.
81.علم الاجتماع السياسي (قضايا العنف السياسي والثورة)، شعبان الطاهر الأسود، الناشر الدار المصرية اللبنانية للطبع والنشـر والتوزيع، 2003م.
82.علم الاجتماع السياسي، مولود زايد الطيّب، الناشر دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، ط1، 2007م.
83.علم الثورة في النظرية الماركسية، يوري كرازين، ترجمة سمير كرم، بيروت ـ لبنان، الناشر دار الطليعة، ط1، 1975م.
84.عمدة الطالب في أنساب آل أبي طلب، جمال الدين أحمد بن علي ابن عنبة، تحقيق محمد حسن آل طالقاني، الناشر المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ط2، 1380هـ.
(غ)
85.غياث الأُمم في التياث الظلم، أمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني، الناشر مكتبة إمام الحرمين، ط2، 1401هـ.
(ف)
86.فتح الباري شرح صحيح البخاري، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر دار المعرفة، بيروت، ط2.
87.فتح المغيث شرح ألفية الحديث، شمس الدين محمّد بن عبد الرحمن السخاوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1403هـ.
88.فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الناشر عالم الكتب، بيروت.
89.الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، تحقيق علي شيري، الناشر دار الأضواء، ط1، 1411هـ.
90.الفخري في الآداب السلطانية، محمّد بن علي بن طباطبا بن الطقطقي. خالٍ من البيانات.
91.الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، علي بن محمد بن أحمد بن الصباغ المالكي، تحقيق سامي الغريري، الناشر دار الحديث، قم، ط1، 1422هـ.
92.فضائل الصحابة، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: د. وصي الله محمد عباس، الناشر مؤسّسة الرسالة، بيروت، ط1، 1403هـ.
93.الفتنة الكبرى، طه حسين، الناشر دار المعارف، مصر.
94.الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق عبد الرحمن يحيى المعلمي، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1407هـ.
(ق)
95.القانون الدستوري، حسن مصطفى البحري، ط1، 1430هـ، 2009م.
96.قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق خليل محيي الدين، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، ودمشق، ط1، 1405هـ/1985م.
97.قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمّد جمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1399هـ.
(ك)
98.الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني البغدادي، تعليق علي أكبر الغفاري، الناشر دار الكتب الإسلامية، ط5، 1363ش.
99.الكامل في التاريخ، عزّ الدين أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الأثير الجزري، الناشر دار صادر، دار بيروت، طبعة عام1386هـ.
100. الكامل في ضعفاء الرجال، عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني، قراءة وتدقيق يحيى مختار غزاوي، الناشر دار الفكر، بيروت، ط3، 1409هـ.
101. كامل الزيارات، جعفر بن محمد بن قولويه القمّي، الناشر مؤسّسة نشر الفقاهة، ط1، 1417هـ.
102. كتاب السنّة، أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني ابن أبي عاصم الضحّاك، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة، بقلم محمد ناصر الألباني، الناشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، 1413م.
103. الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1422هـ.
104. كشف الأستار عن زوائد البزّار على الكتب الستّة، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسّسة الرسالة، ط1، 1399هـ.
105. الكُنى والأسماء، أبو بشر محمّد بن أحمد الدولابي، تحقيق أبو قتيبة نظر محمّد الفارابي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1421هـ.
106. كشف الخفاء ومزيل الالتباس عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1408هـ.
(ل)
107. لُباب النقول في أسباب النزول، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تصحيح أحمد عبد الشافي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان.
108. لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، الناشر دار صادر، بيروت، ط1.
109. اللهوف في قتلى الطفوف، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، الناشر أنوار الهدى، قم ـ إيران، ط1، 1417هـ.
(م)
110. مجموع الفتاوى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق عبد الرحمن ابن محمّد العاصمي وابنه محمّد، الناشر مكتبة ابن تيمية، ط2.
111. مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضـرمي، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط4.
112. مثير الأحزان، نجم الدين محمد بن جعفر بن نما الحلي، الناشر المطبعة الحيدرية، النجف، 1369هـ/1950م.
113. المختصر من أخبار البشر، إسماعيل بن علي أبو الفداء، عماد الدين، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان.
114. المعجم الفلسفي، جميل صليبا، الناشر دار الكتاب اللبناني، بيروت ـ لبنان، 1982م.
115. أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد الأصبهاني، مقاتل الطالبيين، تقديم وإشراف كاظم المظفر، الناشر المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، ط2، 1385هـ.
116. مسند أبي داود، سليمان بن داود الطيالسـي، الناشر دار المعرفة ـ بيروت.
117. المدخل لدراسة القانون، عمر طه بدوي محمد، طُبع سنة 1428هـ/2007م.
118. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمّد الفيومي، الناشر دار الفكر للطباعة والنشر.
119. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد القاري، تحقيق جمال عيتاني، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1422هـ.
120. مآثر الإنافة في معالم الخلافة، أحمد بن عبد الله القلقشندي، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، الناشر مطبعة حكومة الكويت، ط2، 1985م.
121. مناقب الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب×، محمّد بن سليمان الكوفي، تحقيق محمّد باقر المحمودي، الناشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم المقدّسة، ط1، 1412هـ.
122. المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلّفين في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر دار الدعوة.
123. مروج الذهب ومعادن الجوهر، عليّ بن الحسين المسعودي، الناشر دار الهجرة، قم ـ إيران، ط2، 1404هـ/1984م.
124. المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، الناشر الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية، 1403هـ/1983م.
125. المجموع (شرح المهذّب)، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر دار الفكر، بيروت.
126. المنح المكيّة في شرح الهمزية، أبو العباس الهيتمي أحمد بن محمّد بن علي بن حجر المكي، المسمّى أفضل القِرى لقرّاء أمّ القرى، عني بتحقيقه والتعليق عليه: أحمد جاسم المحمّد وبوجمعة بكري، الناشر دار المنهاج، بيروت، ط2، 1426هـ.
127. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة عام 1408هـ/1988م.
128. المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي، تحقيق وتعليق سعيد اللحام، دار الفكر للطباعة، بيروت، ط1، 1409هـ.
129. المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق وتخريج وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي، منشورات المجلس العلمي.
130. المعجم الأوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمين، دار الحرمين، القاهرة، طبعة عام 1415هـ.
131. المعجم الصغير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الكتب العلمية، بيروت.
132. المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق وتخريج حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط2.
133. المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشتري، دار العاصمة، دار الغيث، السعودية، ط1، 1419هـ.
134. مسند أبي يعلى، أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، الناشر دار المأمون للتراث.
135. مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، الناشر: دار صادر ـ بيروت. ونشر: مؤسسة قرطبة ـ القاهرة، تحقيق وتعليق: شعيب الأرنؤوط. ونشر: دار الحديث ـ القاهرة، شرحه وصنع فهارسه: أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد الزين، ط1ـ 1416هـ.
136. المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي،إشراف د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر دار المعرفة، بيروت.
137. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي، تحقيق ماجد أحمد العطية.
138. مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، عليّ بن محمّد بن المغازلي، تحقيق وتعليق محمّد باقر البهبودي، دار الأضواء، بيروت، طبعة عام 1424هـ.
139. معجم البلدان، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، طبعة عام1399هـ.
140. المنتظم في تاريخ الأُمم والملوك، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط1، 1412هـ.
141. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، الناشر مؤسّسة قرطبة، بيروت، ط1، 1406هـ.
142. مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، الموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي، تحقيق الشيخ مالك المحمودي، الناشر جماعة المدرّسين، قم، ط2، 1414هـ .
143. المواقف في علم الكلام، عضد الدين عبد الرحمن الشافعي الإيجي، تحقيق عبد الرحمن عميرة، الناشر دار الجيل، ط1، 1417هـ.
144. مواقف المعارضة في عهد يزيد بن معاوية، محمّد بن عبد الهادي الشيباني، الناشر دار طيبة، الرياض ـ السعودية، ط2، 1430هـ.
145. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار المعرفة، بيروت، ط1، 1382هـ/1963م.
(ن)
146. النجوم الزاهرة في ملوك مصـر والقاهرة، يوسف بن تغري الأتابكي، الناشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسّسة المصـرية العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر.
147. نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي، المالكي حسن بن فرحان، الناشر مؤسّسة اليمامة الصحفية، طبعة عام 1418هـ.
148. النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدّين أبو السعادات المبارك بن محمّد بن الأثير الجزري، تحقيق محمود محمّد الطناحي، الناشر مؤسّسة إسماعيليان، قم، ط4، 1364ش.
149. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الاخبار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، الناشر دار الجيل، بيروت، طبعة عام 1973م.
150. نقد كتاب أُصول مذهب الشيعة، محمد القزويني مع اللجنة العلمية، الناشر مؤسّسة ولي عصر للدراسات الإسلامية، قم ـ إيران، ط1، 1434هـ/2013م.
151. نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، تحقيق مفيد قمحية وجماعة، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1424هـ.
(هـ)
152. هدي الساري مقدمة فتح الباري، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1408هـ.
(و)
153. الوجيز في القانون الدستوري، حسني بوديار، الناشر دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر.
المجلات والدوريات
1. مجلّة القانون والاقتصاد، العدد الرابع، ديسمبر1959م، عبد المنعم البدراوي، مقال بعنوان: القانون المقارن، تعرّف به وبتاريخه.
2. مجلة الجديد، العدد263، 15ديسمبر 1982م، حسني درويش، مقال بعنوان: نحو ثقافة قانونية مبسطة، لا يُعذر المرء بالجهل بالقانون.
3. مجلة الإصلاح الحسيني، العدد2، السنة الأُولى، 1434هـ، حكمت الرحمة، مقال بعنوان: الثورة على عثمان وموقف عليّ منها.
4. مجلّة المجمع العلمي العراقي، العدد75، السنة 1414هـ، منذر الشاوي، مقال بعنوان: القانون الدولي، أساسه وطبيعته.
5. مجلّة الإسلام اليوم، العدد90، حزيران(جون) 2012م، محمّد سيّد بركة، مقال بعنوان: الثورة مفهومها وأسبابها.
6. مجلّة الديموقراطية، العدد52، أكتوبر 2013هـ، وفاء علي داود، مقال بعنوان: التأصيل النظريلمفهوم الثورة، والمفاهيم المرتبطة بها.
المواقع الإلكترونية
1. عبد الهادي عبّاس، مقال بعنوان: حق الإنسان في مقاومة القوانين الجائرة، مجلّة معابر، منشور على شبكة الأنترنت:
http: //www.maaber.org/issue_january05/non_violence1.htm
2. عبد الله السلمو، مقال بعنوان: دراسة قانونية الثورات العربية والقانون الدولي، منشور على الأنترنت:
https: //www.zamanalwsl.net/news/22805.html
3. قادري سمية، شنين محمد مهدي، مقال بعنوان: سيسيولوجيا الثورة، منشور على الموقع التالي:
http: //bohothe.blogspot.com/2011/04/blog-post.html
4. الموسوعة الحرة، موقع ويكيبيديا:
http: //ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9
[1] المائدة: آية55.
[2] الأحزاب: آية6.
[3] اُنظر: الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي): ج4، ص80.
[4] اُنظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير: ج2، ص292.
[5] الآلوسي، محمود بن عبد الله، روح المعاني: ج6، ص167.
[6] المصدر نفسه: ج6، ص186.
[7] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، لباب النقول: ص81.
[8] اُنظر: الحاكم الحسكاني، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل: ج1، ص225.
[9] اُنظر: الثعلبي، أحمد بن محمد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي): ج4، ص80.
[10] اُنظر: الحاكم الحسكاني، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل: ج1، ص215.
[11] اُنظر: ابن الأثير، المبارك بن محمد، جامع الأُصول في أحاديث الرسول: ج8، ص664. الطبري، أحمد بن عبد الله، الرياض النضـرة في مناقب العشـرة: ج3، ص208، وقال: أخرجه الواحدي، وأبو الفرج، والفضائلي.
[12] الحاكم الحسكاني، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل: ج1، ص236. واُنظر: الخوارزمي، محمد بن أحمد، المناقب: ص265.
[13] اُنظر: الحاكم الحسكاني، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل: ج1، ص216 ـ 219.
[14] اُنظر: القزويني، محمد، نقد كتاب أُصول مذهب الشيعة: ج1، ص440 ـ 453.
[15] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ج1، ص194.
[16] اُنظر: القاسمي، محمد، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: ص109.
[17] اُنظر: السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: ج1، ص73.
[18] التوبة: آية74.
[19] اُنظر مثلاً: القزويني، محمد، نقد كتاب أُصول مذهب الشيعة: ج1، ص427 ـ 519.
[20] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج4، ص370. النسائي، أحمد بن شعيب، تهذيب خصائص الإمام علي: ص81 ـ 82. ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبان: ج15، ص376.
[21] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص104.
[22] الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج4، ص331، ح1750.
[23] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج8، ص335.
[24] المصدر نفسه: ج14، ص277.
[25] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج7، ص61.
[26] الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج4، ص343.
[27] الأحزاب: آية6.
[28] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج7، ص123.
[29] البوصيري، أحمد بن أبي بكر، إتحاف الخيرة المهرة: ج7، ص210.
[30] ابن حجر، أحمد بن علي، المطالب العالية: ج16، ص142.
[31] النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى: ج5، ص45 ـ 46.
[32] ابن كثير، إسماعيل، البداية والنهاية: ج5، ص228 ـ 229.
[33] المصري الشافعي، سامي بن أنور، الزهرة العطرة في حديث العترة: ص69 ـ 70.
[34] القاري، علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح: ج9، ص3974.
[35] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج6، ص3.
[36] المصدر نفسه: ج6، ص4.
[37] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج8، ص127.
[38] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج1 ص398ـ 406.
[39] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج13، ص183.
[40] البوصيري، أحمد بن أبي بكر، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: ج7، ص83.
[41] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج4، ص28، وص62.
[42] اُنظر: البحري، حسن مصطفى، القانون الدستوري: ص19. بوديار، حسني، الوجيز في القانون الدستوري: ص8.
[43] مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ج2، ص763.
[44] بوديار، حسني، الوجيز في القانون الدستوري: ص8.
[45] حسني درويش، مقال بعنوان: (نحو ثقافة قانونية مبسطة، لا يعذر المرء بالجهل بالقانون)، مجلة الجديد، العدد263، 15ديسمبر 1982م: ص28.
[46] عمر طه بدوي محمّد، المدخل لدراسة القانون (الكتاب الأوّل، نظرية القانون): ص6.
[47] اُنظر: عمر طه بدوي محمّد، المدخل لدراسة القانون: ص6. حسني درويش، مقال بعنوان: (نحو ثقافة قانونية مبسطة، لا يُعذر المرء بالجهل بالقانون)، مجلّة الجديد، العدد263، 15ديسمبر 1982م: ص28.
[48] البحري، حسن مصطفى، القانون الدستوري: ص21.
[49] البدراوي، عبد المنعم، مقال بعنوان: (القانون المقارن، تعرّف به وبتاريخه)، مجلّة القانون والاقتصاد، العدد الرابع، ديسمبر 1959م.
[50]حسني درويش، مقال بعنوان: (نحو ثقافة قانونية مبسطة، لا يُعذر المرء بالجهل بالقانون)، مجلّة الجديد، العدد263، 15ديسمبر1982م: ص28.
[51] اُنظر: بوديار، حسني، الوجيز في القانون الدستوري: ص15. الشاوي، منذر، مقال بعنوان: (القانون الدولي، أساسه وطبيعته) مجلّة المجمع العلمي العراقي، العدد 75، السنة 1414هـ.
[52] اُنظر: البحري، حسن مصطفى، القانون الدستوري: ص22. عمر طه بدوي محمّد، المدخل لدراسة القانون: ص8 ـ 12.
[53] القاضي المغربي، النعمان بن محمد، شرح الأخبار: ص430.
[54] المصدر نفسه: ص431.
[55] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج4، ص161.
[56] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج1، ص224.
[57] أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ج2، ص347.
[58] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج1، ص10.
[59] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص108 ـ 109.
[60] العاديات: آية3 ـ 4.
[61] الروم: آية9.
[62] مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ص102.
[63] الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير: ج1، ص87.
[64] مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: ص102.
[65] جميل صليبا، المعجم الفلسفي: ص58.
[66] المصدر السابق: ج1، ص381.
[67] وفاء علي داود، مقال بعنوان: (التأصيل النظريلمفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة بها)، مجلّة الديموقراطية، العدد52، أكتوبر 2013م.
[68] محمّد سيّد بركة، مقال بعنوان: (الثورة مفهومها وأسبابها)، مجلة الإسلام اليوم، العدد 90، حزيران (جون) 2012م.
[69] وفاء علي داود، مقال بعنوان: (التأصيل النظريلمفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة بها)، مجلّة الديموقراطية، العدد52، أكتوبر 2013م. واُنظر: الموسوعة الحرة، موقع ويكيبيديا:
http: //ar.wikipedia.org
[70] اُنظر: مولود زايد الطيب، علم الاجتماع السياسي: ص99. شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي قضايا العنف السياسي والثورة: ص47.
[71]يوري كرازين، علم الثورة في النظرية الماركسية (ترجمة سمير كرم): ص31.
[72] اُنظر: وفاء علي داود، مقال بعنوان: (التأصيل النظريلمفهوم الثورة والمفاهيم المرتبطة بها)، مجلّة الديموقراطية، العدد52، أكتوبر 2013م. قادري سمية وشنين محمد مهدي، مقال بعنوان: (سيسيولوجيا الثورة)، منشور على الموقع التالي:
[73] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج2، ص456. الجوهري، أحمد بن عبد العزيز، السقيفة وفدك: ص57.
[74] اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج2، ص328. الجوهري، أحمد بن عبد العزيز، السقيفة وفدك: ص58. ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج7، ص23.
[75]اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج1، ص581.
[76] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص194.
[77] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج7، ص24.
[78] اُنظر: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج7، ص24.
[79] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص194.
[80] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج2، ص458.
[81] المصدر نفسه: ج2، ص443.
[82] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج7، ص25. واُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص194.
[83] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج1، ص583.
[84] البخاري، محمد بن أسماعيل، صحيح البخاري: ج6، ص26.
[85] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج1، ص581. الجوهري، أحمد بن عبد العزيز، السقيفة وفدك: ص57. ذكر أنّ الذي جاء بالخبر هو معن، ولم يذكر الآخر. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج6، ص19. فقد نقل عن الزبير بن بكار، أنّه قال: «وقد كان مالأ أبا بكر وعمر على نقض أمر سعد وإفساد حاله رجلان من الأنصار ممّن شهدا بدراً، وهما عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. ونقل الخبر عن المدائني والواقدي أيضاً، فقال: «وذكر المدائني والواقدي أنّ معن ابن عدي اتّفق هو وعويم بن ساعدة على تحريض أبى بكر وعمر على طلب الأمر وصرفه عن الأنصار، قالا: وكان معن بن عدي يشخصهما إشخاصاً، ويسوقهما سوقاً عنيفاً إلى السقيفة؛ مبادرةً إلى الأمر قبل فواته. واُنظر أيضاً: المكي، الزبير بن بكار، الموفقيات: ص469، حيث ذكر خبر تكريم قريش لهما، وإدانتهما من الأنصار بسبب الوشاية المذكورة.
[86] اُنظر: المعتزلي، ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج6، ص21.
[87] اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص124.
[88] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج8، ص26.
[89] المصدر نفسه: ج5، ص83.
[90] اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص124.
[91] الطبري، أحمد بن عبد الله، الرياض النضرة: ج1، ص241.
[92] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أُسد الغابة: ج3، ص339.
[93] اُنظر: أبو الفداء، إسماعيل، المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء): ج1، ص156.
[94] اُنظر: المكي، الزبير بن بكار، الموفقيات: ص471.
[95] اُنظر: اليعقوبي، محمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص126.
[96] اُنظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج5، ص82. النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج5، ص154.
[97] أبو يعلى، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى: ج13، ص366.
[98] ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف: ج7، ص485. النميري، عمر بن شبة، تاريخ المدينة: ج2، ص671.
[99] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج8، ص111.
[100] اُنظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص153.
[101] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج3، ص296.
[102] اُنظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج3، ص1103.
[103] اُنظر: ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج3، ص61.
[104] النميري، عمر بن شبة، تاريخ المدينة: ج3، ص930.
[105] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج9، ص55، عن كتاب الشورى ومقتل عثمان لعوانة، والسقيفة للجوهري.
[106] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج1، ص286 ـ 287. ومنشِم ــ بكسر الشين ـ: اسم امرأة كانت بمكّة عطّارة، وكانت خزاعة وجُرهم إذا أرادوا القتال تطيّبوا من طيبها، وكانوا إذا فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم، فكان يُقال: أشأم من عطر منشِم. فصار مثلاً. اُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: ج5، ص2041.
[107] وقد ذكرنا نبذاً من تلك السياسات والظروف التي أدّت بالثورة على عثمان، في مقالٍ لنا بعنوان: (الثورة على عثمان وموقف عليّ منها)، مجلة الإصلاح الحسيني، العدد2، السنة الأُولى، 1434هـ.
[108] اُنظر: الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص95.
[109] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص438.
[110]اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص462.
[111]اُنظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص179.
[112]اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج3، ص512.
[113] محمد عبده، شرح نهج البلاغة: ج1، ص89.
[114] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج1، ص269.
[115] المصدر السابق: ج7، ص37 ـ 38.
[116]اُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي: ص722. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج7، ص41.
[117] طه حسين، الفتنة الكبرى: ج1، ص120.
[118] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص278، وص291.
[119] اُنظر في ذلك: المالكي، حسن فرحان، نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي: ص279 ـ 280.
[120] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحى، أنساب الأشراف: ج2، ص330.
[121] اُنظر: المصدر نفسه: ج2، ص323، وص327. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج2، ص206.
[122] اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص319، وص328، وص334. الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص208.
[123] اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص329 ـ ص333. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأُمم: ج5، ص126ـ 128، وص137.
[124] أبو الفداء، إسماعيل، المختصر في أخبار البشـر (تاريخ أبي الفداء): ج1، ص182. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الإرب في فنون الأدب: ج20، ص138.
[125] اُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص34.
[126] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص9 ـ 10.
[127] اُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص38.
[128] أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص39.
[129] اُنظر: المصدر نفسه: ص39 ـ 40.
[130] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص10.
[131] اُنظر: المصدر نفسه: ج2، ص12.
[132] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص42.
[133] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ج1، ص221.
[134] اُنظر: اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص214.
[135] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص122.
[136] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص13.
[137] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص14.
[138] وسيأتي مناقشة هذا الشرط بنحوٍ من التفصيل.
[139][139] اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4، ص291. وذكرها البلاذري بنحوٍ من الاختصار. اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص42.
[140] آل ياسين، راضي، صلح الحسن×: ص259 ـ 260.
[141] اُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4، ص291.
[142] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص42.
[143] اُنظر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص23.
[144] اُنظر: الشافعي، محمد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ص357.
[145] اُنظر: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص399.
[146] ابن الصباغ المالكي، علي بن محمد، الفصول المهمّة: ص729.
[147] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص41.
[148] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص28. ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص22، عن المدائني.
[149] قال الهيثمي: «رواه الطبراني ورجاله ثقات. الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص172.
[150] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص93. ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم): ج9، ص3132.
[151] ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص24، عن المدائني. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4، ص285.
[152] الراوندي، قطب الدين، الخرائج والجرائح: ج2، ص576.
[153] الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ص211.
[154] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج1، ص387.
[155] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج13، ص56.
[156] اُنظر: ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة: ج2، ص64. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص45.
[157] الصالحي الشامي، محمد بن يوسف، سبل الهدى والرشاد: ج11، ص67.
[158] ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة: ج2، ص65.
[159] ابن قتيبة الدينوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج1، ص140.
[160] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تاريخ الخلفاء: ص191.
[161] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص41 ـ 42.
[162] اُنظر: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، الصواعق المحرقة: ج2، ص399.
[163] اُنظر: البري، محمد بن أبي بكر، الجوهرة في نسب الإمام علي: ص26.
[164] المزي، يوسف، تهذيب الكمال: ج6، ص250.
[165] وهنا نحن نناقش الدكتور فيما يخصّ الفقرة أعلاه بما يتبنّاه هو نفسه، وبما هو مشهور عند الفريقين من تفكّك جيش الإمام× وتقاعسه عن القتال، بغضّ النظر عن الرأي الآخر الذي يرى قوّة جيش الإمام× وتماسكه.
على أنّنا نرى أنّ الرأي الآخر الذي يتبنى قوّة جيش الإمام× إمّا لا يصمد أمام التحقيق العلمي، أو لا يتنافى مع اشتراط الخلافة؛ لأنّ الاعتقاد بقوّة جيش الإمام× إنْ كان ناشئاً من رواية جبير المصـرّحة بتنازله عن الخلافة، وعدم رغبته بالعود إليها، فهو لا يصمد أمام التحقيق؛ لاقتضائه تقديم روايات اشتراط الخلافة، لورود أخبار صحيحة بها، ولأنّها تتوافق مع تصـريح الحسن× بإمامته، ولمخالفتها للسير التاريخي الذي يُنبئ عن تململ كبير في جيش الإمام× الذي كان عبارة عن خليط غير متجانس، وغير مقتصر على شيعته المعتقدين بإمامته. ومن الواضح أنّ المؤلّف اعتمد على رواية جبير المتقدّمة، وهي لا تصمد عند المعارضة كما أوضحنا، هذا أوّلاً.
وثانياً: هي مخالفة لرأي المؤلّف نفسه وما يتبناه من تفكّك جيش الإمام× وضعفه.
وإن كان الاعتقاد بقوّة جيش الإمام الحسن× ناشئاً من تحليل آخر لمجريات الأُمور، وبغضّ النظر عن رواية جبير، فهذا لا يتنافى مع اشتراط الخلافة، بل هو الأوفق بالاشتراط، ويتناغم وينسجم مع اعتقاد الإمام× بأحقيّته وأولويته بالخلافة؛ إذ لا مبرّر مع قوّته وسيطرته على الأوضاع أنْ يتنازل مطلقاً عن حقٍّ يعتقد أنّه أمرٌ إلهي، وأنّه أولى به من غيره، كما صرّح بذلك مراراً وفي خطبٍ عديدة.
[166] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج13، ص55.
[167] اُنظر: الشيباني، محمد بن عبد الهادي، مواقف المعارضة في عهد يزيد: ص134ـ 142.
[168] المصدر السابق: ص143.
[169] ابن عنبة، أحمد بن علي، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص67.
[170]ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص12.
[171] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج5، ص175.
[172][172] المصدر السابق: ج5، ص175.
[173] ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبّان: ج11، ص224. الصنعاني، عبد الرزاق بن همام، المصنف: ج5، ص339.
[174] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج3، ص182.
[175] الشوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار: ج8، ص190.
[176] وردت هذه الزيادة (بعد) في ما نقله صاحب البحار عن علل الشرائع. انظر: المجلسـي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص2.
[177] الصدوق، محمد بن علي، علل الشرائع: ص211.
[178] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج13، ص56.
[179] ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف: ج7، ص251.
[180] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص44.
[181]ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص14. واُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص14، ذكر خطبته في النخيلة.
[182]اُنظر: ابن أبي الحديد، عبد الحميد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص46.
[183] المصدر السابق: ج16، ص17.
[184] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص405. أبو الفداء، إسماعيل، المختصـر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء): ج1، ص183.
[185] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص32. نقلاً عن الكلبي والمدائني.
[186] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص225. واُنظر: الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ج1، ص252.
[187] الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية: ص6.
[188] ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون: ص193.
[189] هود: آية113.
[190] البقرة: آية124.
[191] العلّامة الحلّي، الحسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء: ج9، ص393 ـ 397.
[192] التفتازاني، مسعود بن عمر، شرح المقاصد في علم الكلام: ج2، ص271.
[193] الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الاعتصام: ج2، ص362.
[194] الجويني، عبد الملك بن عبد الله، غياث الأُمم في التياث الظلم: ص84.
[195] الجويني، عبد الملك بن عبد الله، الإرشاد: ص426.
[196] القلقشندي، أحمد بن علي، مآثر الأناقة: ج1، ص37.
[197] اُنظر: النووي، يحيى بن شرف، شرح صحيح مسلم: ج12، ص229.
[198] القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): ج1، ص270.
[199] الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية: ص18.
[200]القلقشندي، أحمد بن علي، مآثر الأناقة: ج1، ص36.
[201] البقرة: آية124.
[202] الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير: ج1، ص138.
[203] الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير: ج4، ص46.
[204] اُنظر: الجصاص، محمد بن علي، أحكام القرآن: ج1، ص84.
[205] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص150.
[206]شيخو، لويس، شعراء النصرانية بعد الإسلام،: القسم الأوّل، ترجمة رقم 14.
[207] انظر: أبي الفدا، إسماعيل، المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء): ج1، ص193. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ دمشق: ج70، ص134.
[208]أبي الفدا، إسماعيل، المختصر في أخبار البشر: ج1، ص193.
[209] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص150.
[210][210] العلايلي، عبد الله، الإمام الحسين: ص59.
[211] الشوكاني، محمد بن علي، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ج1، ص407.
[212] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج7، ص81.
[213] العجلوني، إسماعيل بن محمد، كشف الخفاء: ج2، ص420.
[214] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج8، ص27.
[215] قال ابن كثير في تأويل الحديث أعلاه: «وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأُخراه، أمّا في دنياه، فإنه لمّا صار إلى الشام أميراً، كان يأكل في اليوم سبع مرات، يُجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم سبع أكلات بلحم، ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً، ويقول: والله ما أشبع وإنّما أعيا، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كلّ الملوك. وأمّا في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث بالحديث الذي رواه البخاري، وغيرهما من غير وجهٍ، عن جماعة من الصحابة، أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) قال: (اللهم إنّما أنا بشـر، فأيما عبد سببته، أو جلدته، أو دعوت عليه، وليس لذلك أهلاً، فاجعل ذلك كفارةً وقربةً تقرّبه بها عندك يوم القيامة). فركّب مسلم من الحديث الأول، وهذا الحديث فضيلة لمعاوية، ولم يورد له غير ذلك.ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص128.
ونترك التعليق للقارئ اللبيب، ليرى كيف يتمّ تأويل النصوص، بل والتنقيص من النبيّ’ من أجل تبرئة معاوية!
[216] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص134.
[217] العلوي، محمد بن عقيل، العتب الجميل: ص25.
[218] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد بتحقيق شعيب الأرنؤوط: ج5، ص347.
[219] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج5، ص42.
[220] أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود: ج2، ص275 ـ 276.
[221] الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج3، ص9، ح1011.
[222] النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي: ج7، ص176 ـ 177.
[223] الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج3، ص9، ح1011.
[224]أبو الفداء، إسماعيل، المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء): ج1، ص186.
[225] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17.
[226] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص12.
[227] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص504.
[228] اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص220.
[229] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص325. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج38، ص212. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الأُمم والملوك: ج5، ص285.
[230]اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص228.
[231] المصدر السابق: ج2، ص228.
[232] العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: ص194.
[233] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص319.
[234] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج5، ص66.
[235] العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: ص181.
[236] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص369. ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الأُمم والملوك: ج6، ص7.
[237]الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص368. واُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص320.
[238] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج6، ص262.
[239] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص328. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص119. واللفظ للثاني.
[240] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص320.
[241] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص275.
[242] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص286.
[243]المصدر نفسه: ج5، ص287.
[244] المصدر نفسه: ج5، ص288.
[245] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج65، ص407.
[246] المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب: ج3، ص68.
[247] ابن الطقطقي، محمد بن علي، الفخري في الآداب السلطانية: ص16.
[248]ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص258.
[249] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص252.
[250] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج4، ص37ـ 38.
[251] اُنظر: النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج1، ص61.
[252] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص30.
[253] الذهبي، محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال: ج4، ص440.
[254] ابن حجر، أحمد بن علي، تعجيل المنفعة: ص453.
[255] ابن تغري، يوسف، النجوم الزاهرة: ج1، ص163.
[256] الحلبي، علي بن برهان الدين، السيرة الحلبية: ج1، ص267.
[257] الآلوسي، محمود بن عبد الله، تفسير روح المعاني: ج26، ص78.
[258] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج4، ص37.
[259] ابن حجر، أحمد بن علي، تعجيل المنفعة: ص453.
[260] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص243.
[261] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ج3، ص412.
[262]ابن حزم الظاهري، علي بن أحمد، جوامع السيرة: ص357.
[263] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج54، ص183.
[264] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص26.
[265] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج3، ص232.
[266] اُنظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة: ج4، ص544، وص572.
[267] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج6، ص74.
[268]اُنظر: النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج1، ص61.
[269] الحموي، ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان: ج2، ص304.
[270] ابن سعد، محمد، الطبقات الكبرى: ج7، ص467.
[271] ابن حجر، أحمد بن علي، مقدمة فتح الباري: ص392.
[272] اُنظر: المصدرنفسه.
[273]المصدرنفسه: ج6، ص74.
[274] المناوي، محمد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج3، ص109.
[275] المصدر السابق: ج5، ص334.
[276] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج3، ص354.
[277] اُنظر: المصدر نفسه: ج4، ص55 ـ 56.
[278] فهؤلاء خمسة من الصحابة رووا هذا الحديث، وبعض طرقه صحيحة أيضاً. اُنظر: الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج3، ص306 ـ 307.
[279] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج2، ص222.
[280] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص244.
[281] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص177 ـ 178.
[282] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج13، ص8.
[283] المصدر نفسه.
[284] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص86.
[285] اُنظر: ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص503 ـ 504.
[286] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص504 ـ 505.
[287]اُنظر: ما تقدّم في الكامل في التاريخ: ج3، ص507. والرواية الأخيرة صحيحة الإسناد، وردت من عدّة طرق، فقد أخرج النسائي والحاكم بسندهما إلى محمّد بن زياد، قال: «لمّا بايع معاوية لابنه، قال مروان: سنّة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: سنّة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذي أنزل اللهفيه: (وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا). الآية، فبلغ ذلك عائشة، فقالت: كذب والله ما هو به، ولو شئتُ أن أُسمّي الذي أنزلت فيه لسمّيته، ولكنّ رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) لعن مروان ومروان في صلبه، فمروان فضض من لعنة الله. النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى: ج6، ص459. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج4، ص481. وصحّح إسناده الحاكم في المستدرك: (ج4، ص481)، والألباني في صحيحته: ج7، ص722. وأخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الله بن المديني، قال: «إنّي لفي المسجد حين خطب مروان، فقال: إنّ الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناً، وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية؟! إنّ أبا بكر والله، ما جعلها في أحد من ولده، ولا أحد من أهل بيته، ولا جعلها معاوية في ولده إلّا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الَّذِي قالَ لِوالِدَيْه أُفٍّ لَكُما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أباك. قال: وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان، أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟! كذبت، ما فيه نزلت، ولكن نزلت في فلان بن فلان. ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد، تفسير ابن أبي حاتم (تفسير القرآن العظيم): ج10، ص3295. قال الألباني: «وهو إسنادٌ صحيح. الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج7، ص721 ـ 722. والحديث أخرجه البخاري مختصراً في صحيحه.
[288] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص507.
[289] اُنظر: ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة: ج4، ص276.
[290] المقدسي، مطهر بن طاهر، البدء والتاريخ للمقدسي: ج6، ص6 ـ 7.
[291] العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: ص164.
[292] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص507. واُنظر: ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج4، ص332 ـ 333.
[293]المصدر نفسه.
[294] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب: ج2، ص830.
[295] العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: ص161. والرواية صحيحة السند، رجالها ثقات.
[296] المصدر نفسه: ص161.
[297] أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص48.
[298] العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: ص161.
[299] أبو يعلى الفرّاء، محمّد بن الحسين، الأحكام السلطانيّة: ص25.
[300] اُنظر: القلموني، رشيد رضا، الخلافة: ص42.
[301]القلموني، رشيد رضا، الخلافة: ص52ـ 53.
[302] زيدان، عبد الكريم، أُصول الدعوة: ص201 ـ 203.
[303] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج3، ص207، وج1، ص115.
[304][304] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج4، ص198. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص387.
[305] ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة: ج7، ص258.
[306] النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبيين: ج7، ص263 ـ 264.
[307][307] الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد، المواقف: ج3، ص591. وقوله: ولم ينكر عليهم أحد. غير صحيح؛ إذ إنّ الكثير من الصحابة لم يبايعوا أبا بكر، كما أنّ الخلافات على أوجها في عقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، فلا نفهم ماذا يعني بقوله: ولم ينكر عليهم أحد.
[308] اُنظر: الماوردي، علي بن محمد، الأحكام السلطانية: ص7.
[309]النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبيين: ج7، ص264.
[310] المصدر نفسه: ج7، ص266.
[311] العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: ص161.
[312] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص14.واُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص250. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص299.
[313] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص300.
[314] الدينوري، أحمد بن داوُد، الأخبار الطوال: ص253.
[315] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص262.
[316]الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص255.
[317] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج7، ص47.
[318] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج5، ص13.
[319][319] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص165. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص290.
[320] ونحن في هذا البحث لا نريد الدخول في الآيات والروايات الدالّة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنّ ذلك محقّق في محلّه في كتب الفقهاء.
[321] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21.
[322] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص304.
[323] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص81.
[324] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص114 ـ 115. واُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص305.
[325] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص266.
[326] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص14.
[327]الوارد في بعض المصادر هو (فداك) ولعله الأنسب والأصح. انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج4، ص20.
[328] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص261.
[329] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص217.
[330] اُنظر: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص208 ـ 211.
[331] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص17. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص18.
[332] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج4، ص172. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص324. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص116.
[333] إذ إنّ هذه المسألة خلافية، فقد يُقال بعدم علمه بذلك، أو علمه بذلك بصورة مجملة، لا على نحو التفصيل، أو أنّ علمه بذلك على نحو الغيب، وهو مأمور بالتعامل بحسب الظاهر، أو غير ذلك، لكن كما تقدّم من البحث، فقد انتهينا إلى أنّ علم الحسين×، ومعرفته بقتله علماً عاديّا، وغير مرتبط بالغيب، فليس الصحابة والتابعين الذين كانوا يتوقّعون ذلك بأفضل حال من الحسين× وقرائته للواقع، وما تمليه عليه الظروف، وحينئذٍ قد يتنافى هذا العلم مع إرساله مسلم بن عقيل إلى الكوفة.
[334] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص120.
[335] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص192.
[336]الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص289. ونحوه في أنساب الأشراف: ج3، ص164.
[337] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص25.
[338] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص76. وأخرج هذا القول الطبري في تاريخه: ج4، ص269، وابن عساكر في تاريخه: ج14، ص216.
[339] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص157.
[340]محمّد عبده، شرح نهج البلاغة: ج3، ص51.
[341] اُنظر: عبد الهادي عباس، مقال تحت عنوان: (حقّ الإنسان في مقاومة القوانين الجائرة)، مجلّة معابر، منشور على شبكة الأنترنت:
http: //www.maaber.org/issue_january05/non_violence1.htm
[342] المصدر السابق.
[343]رئيس المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأُستاذ في القانون الدولي في الأكاديمية العربية في الدنمارك، ومستشار قانوني.
[344]السلمو، عبد الله، مقال تحت عنوان: (دراسة قانونية الثورات العربية والقانون الدولي)، منشور على الأنترنت:
https: //www.zamanalwsl.net/news/22805.html
[345] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17.
[346] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج14، ص322، وأخرجه الحاكم وصحّحه، عن عليّ×، أنّ النبيّ’، قال: «رحم الله عليّاً، اللهم أدر الحقَّ معه حيث دار. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص124 ـ 125.
[347] أخرجه ابو يعلى في مسنده: ج2، ص318. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ج7، ص235، وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات.
[348]الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص124، وصحّحه الحاكم والذهبي.
[349]الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص107. ابن عساكر، علي ابن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج82، ص418.
[350] ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري: ج7، ص57.
[351]الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص151، وصحّحه الحاكم والذهبي.
[352]أخرجه الحاكم وصحّحه:الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص156. وأخرجه البخاري بلفظ: «يا فاطمة ألا ترضين أنْ تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأُمّة. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج7، ص142.
[353] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص210.
[354]الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص154.
[355] المصدر نفسه: ج3، ص156.
[356] أخرجه الترمذي وحسّنه: الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص360. والحاكم وصحّحه، ووافقه الذهبي، المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص الذهبي: ج3، ص155.
[357] أخرجه النسائي في: تهذيب خصائص أمير المؤمنين بتحقيق الحويني الأثري: ص94، وقال المحقّق بصحّته. وأخرجه بلفظٍ قريب من ذلك: الترمذي وحسّنه في: سنن الترمذي: ج5، ص362، والحاكم وصحّحه في: المستدرك: ج3، ص154، وص157.
[358] آل عمران: آية61.
[359]الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير: ج8، ص86.
[360] القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): ج4، ص104.
[361] ابن حبّان، محمد، صحيح ابن حبّان: ج15، ص427.
[362] البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج7، ص47. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص322.
[363] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص324. ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج4، ص172.
[364] الأحزاب: آية33.
[365] اُنظر: ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة: ج2، ص69، لكن في مصنّف ابن أبي شيبة نسب القول لعمرو بن العاص، وليس لولده. اُنظر: ابن أبي شيبة، عبد الله، بن محمد، المصنف: ج7، ص269.
[366] الطوسي، محمد بن الحسن، اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): ج1، ص259.
[367] البلاذري، أحمد بن يحيى،أنساب الأشراف: ج3، ص155.
[368] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص206.
[369] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص261.
[370] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص207.
[371]الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص261.
[372] المصدر نفسه: ج4، ص291.
[373] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص162.
[374] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص244.
[375] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص162.
[376] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص152.
[377] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص347.
[378] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص165. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص206.
[379] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص152.
[380][380] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص32.
[381] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص158. واُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص262. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص37.
[382] اُنظر: البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص158. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص262.
[383] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص158. الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص262.
[384] المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص38.
[385] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص158.
[386] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص262.
[387] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص158. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص38.
[388] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص294.
[389]سبط ابن الجوزي، يوسف بن فرغلي، تذكرة الخواص: ص514.
[390]الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص230.
[391] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص262.
[392] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص41.
[393] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص243. واُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص281.
[394] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص297.
[395] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص245.
[396] المصدر نفسه: ص231.
[397] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص266.
[398] اُنظر: ابن نما، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص17.
[399] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص265.
[400] ابن نما، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص17.
[401] اُنظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص266.
[402] اُنظر: ابن نما، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص19.
[403] اُنظر: المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص66.
[404] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص263.
[405] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص216.
[406] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص163. واُنظرنحو ذلك: الكوفي، محمد بن سليمان، مناقب أمير المؤمنين: ج2، ص261.
[407] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص249.
[408] وفي أنساب الأشراف: ج3، ص170، والكامل في التاريخ: ج4، ص47: «وجهلتم حقّنا، وهو الصحيح الموافق لسياق الكلام.
[409] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم الملوك: ج4، ص303.
[410] الدينوري، أحمد بن داود، الأخبار الطوال: ص249.
[411] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص305.
[412] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص298. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص72.
[413]العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: ص176.
[414] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص177.
[415] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص311.
[416]المصدر نفسه: ج4، ص323.
[417] في أنساب الأشراف: ولا أفرّ فرار العبيد. اُنظر: ج3، ص188.
[418] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص323.
[419] الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص293.
[420] يونس: آية71.
[421] هود: آية56.
[422] اُنظر: الخطبة باختلاف يسير في ألفاظها في كلّ من: ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج4، ص218 ـ 219. ابن حمدون، محمد بن الحسن، التذكرة الحمدونية: ج5، ص211 ـ 212. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص58 ـ 60. ابن نما، محمد بن جعفر، مثير الأحزان: ص39 ـ 41.
[423] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص300. المفيد، محمد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص75.
[424] والعلم بقتله لا يتعلّق بالعلم الغيبي كما قد يتصوّر، فقد أشرنا سابقاً بأنّ الحسين× قد استشـرف الحالة من خلال ظروف المجتمع، ونؤكّد هنا أنّه إذا كان الصحابة أمثال ابن عبّاس وابن عمر وغيرهم كانوا شبه موقنين بمقتل الحسين×، وهم ليسوا بجلالته وقدره، بل هو سيدهم وكبيرهم، فمن الطبيعي أنْ يشخّص ظروف ذلك المجتمع ويعرف إجرام بني أُميّة، وأنّهم لن يتركوه حتّى يبايع أو يُقتل.
[425] وطبيعيٌّ نحن لا نتكلّم عن الإمام× هنا بما هو معصوم منصوص عليه، فإنّ المسألة تكون بيّنة وواضحة، وسيأتي الكلام عليها، بل نتكلّم عن الإمام× باعتباره شخصية إسلامية مرموقة، ومن أهل البيت^، ومن أهل الحلّ والعقد في ذلك المجتمع.
[426] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص329.
[427] اُنظر: ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج3، ص59. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص328.
[428][428] قال الهيثمي: «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج1، ص170.
[429] اُنظر: ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف: ج7، ص503.
[430] أخرجه البزار كما في كشف الأستار للهيثمي: ج3، ص222.
[431] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص46، وج12، ص27. الجرجاني، عبد الله ابن عدي، الكامل في ضعفاء الرجال: ج2، ص306.
[432] اُنظر: ابن حنبل، أحمد، فضائل الصحابة: ج2، ص785. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج4، ص9 ـ 10، وج5 ص354 ـ 355. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص46. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الصغير: ج1، ص140. الآجري، محمد بن الحسين، الشـريعة: ج5، ص2215.
[433] اُنظر: الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الصغير: ج2، ص22. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج6، ص85.
[434] اُنظر: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج12، ص90.
[435]اُنظر: الدولابي، محمد بن أحمد، الكُنى والأسماء: ج1، ص232.
[436] اُنظر: ابن المغازلي، علي بن محمد، مناقب أمير المؤمنين×: ص148.
[437] ولكاتب هذه السطور رسالة دكتوراه، بعنوان: (دراسة في حديث السفينة على مباني أهل السنّة)، تضمّنت مباحث عديدة متعلّقة بالحديث، منها: تخريج الحديث، ودراسة أسانيده بصورة مفصّلة، وانتهى فيها إلى صحّة الحديث وفق القواعد المقرّرة عند أهل السنّة. ومنها: دراسة متن الحديث، وبيان دلالاته التي منها مرجعية أهل البيت^ وعصمتهم.
[438]اُنظر: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج2، ص343.
[439] اُنظر: السخاوي، شمس الدين، محمّد بن عبد الرحمن، استجلاب ارتقاء الغرف بحبّ أقرباء الرسول وذوي الشرف: ج2، ص484.
[440] اُنظر: ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، المنح المكيّة في شرح الهمزية: ص535. ابن حجر الهيتمي، أحمد ابن محمد الصواعق المحرقة: ج2 ص445، وص675.
[441] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج7، ص347.
[442] الأحزاب: آية33.
[443] التوبة: آية119.
[444] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج7، ص130. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: ج7، ص501. والحاكم النيسابوري، وصحّحه في المستدرك على الصحيحين: ج3، ص147.
[445] «حامّة الإنسان: خاصّته، ومَن يقرب منه، وهو الحميم أيضاً ابن الأثير، المبارك بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص429.
[446] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص361. وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: ج18، ص272. وحسّنه حمزة أحمد الزين محقّق الكتاب حيث قال: «إسناده حسن. وأورده الذهبي في: سير أعلام النبلاء: ج3، ص283، في ترجمة الحسين الشهيد، قائلاً: «إسناده جيد، رُوي من وجوه عن شهر، وفي بعضها يقول: دخلتُ عليها أُعزّيها على الحسين.
[447] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج7، ص123.
[448] القرطبي، محمد بن أحمد، التذكرة في أحوال الموتى والآخرة: ج3، ص1114 ـ 115.
[449] القاري، علي بن سلطان محمد، مرقاة المفاتيح: ج9، ص3974.
[450] السقاف، حسن بن علي، صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ص653.
[451]الهيتمي، أحمد بن حجر، الصواعق المحرقة: ج2، ص446 ـ 447.
[452]المناوي، محمّد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج2، ص658 ـ 659.
[453] السمهودي، علي بن أحمد، جواهر العقدين: ص236 ـ 264.
[454] كما هو واضح من عباراتهم الآنفة الذكر، بل صرّح بعضهم بأنّ المراد من أهل بيته في هذا المقام العلماء منهم. اُنظر: المناوي، محمّد عبد الرؤوف، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج2، ص659.
[455] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج3، ص3، وص62، وص82.
[456] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص321.
[457][457] النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى: ج5، ص149.
[458] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص321.
[459] الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2، ص423.
[460] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج5، ص391.
[461] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص326.
[462]الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2، ص326.
[463] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص الذهبي: ج3، ص167.
[464] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة: ص286. الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2، ص423 ـ 432.
[465] اُنظر: السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة: ص286.
[466]الألباني، محمد بن نوح، سلسلة الأحاديث الصحيحة: ج2، ص431.
[467] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص442.
[468] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الصغير: ج2، ص3. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص149.
[469] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص360. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص149.
[470]الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص الذهبي: ج3، ص149.
[471] ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبّان: ج15، ص434.
[472] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ج3، ص152 ـ 154.
[473] الفخر الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير: ج27، ص166.
[474] النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى: ج5، ص50.
[475] ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، المصنف: ج7، ص511.
[476] ابن خزيمة، محمد بن إسحاق، صحيح ابن خزيمة: ج2، ص48. ابن حبان، محمد، صحيح ابن حبّان: ج14، ص427.
[477] ابن حجر، أحمد بن علي، الإصابة: ج2، ص63.
[478] المصدر نفسه.
[479]الألباني، محمد بن نوح، صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: ج2، ص376.
[480] أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داود: ص327.
[481] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص180.
[482]الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص180.
[483] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص166.
[484] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص440.
[485] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك وبذيله تلخيص الذهبي: ج3، ص166.
[486] النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى: ج5، ص49.
[487] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص288.
[488] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص48.
[489] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد بتحقيق أحمد محمد شاكر: 7ج، ص519، ح (7863).
[490] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج4، ص172. الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص324. ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص116. وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك وصحّحه، ووافقه الذهبي، المستدرك وبذيله تلخيص الذهبي: ج3، ص177.
[491] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص377.
[492] النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج6، ص22.
[493]ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو، كتاب السنّة، ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة بقلم الألباني: ص489.
[494] أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود، مسند أبي داود الطيالسي: ص259.
[495] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأُمم والملوك: ج4، ص313.
[496] ابن جنبل، أحمد، مسند أحمد: ج1، ص242. اُنظر: الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج4، ص398.
[497] الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، وبذيله تلخيص الذهبي: ج4، ص398.
[498]قال النووي: «فقد صحّ عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) أنّه قال: مَن رآني في المنام فقد رآني حقّاً؛ فإنّ الشيطان لا يتمثّل في صورتي. النووي، يحيى بن شرف، المجموع (شرح المهذب): ج6، ص282.
[499] ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج2، ص85.
[500] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9، ص187.
[501]ابن حنبل، أحمد، مسند أحمد: ج6 ص294.
[502] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5 ص104.
[503]الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد: ج9 ص187.
[504] في بعض المصادر كالمستدرك: (يُقبّلها) كما سيأتي.
[505] الذهبي، محمد بن أحمد، تاريخ الإسلام: ج5، ص103.
[506]الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج23، ص308 ـ 309.
[507]الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين وبذيله تلخيص الذهبي: ج4، ص398.