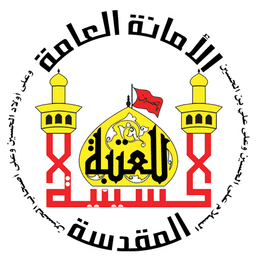بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقية وسعادته الأبدية المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدد اختيارات الإنسان الصحيحة، وعلى ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله على سائر المخلوقات، واحتجّ عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)([1])، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، وقد جاء في الأثر «العلمُ نورٌ»([2])، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله ، إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)([3])، وبهما تسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمّة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)([4])، و(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)([5])، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاؤهم^ ومبتغاهم من الله} لأنفسهم أيضاً؛ إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»([6]).
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه هي سيرة الأنبياء والأئمّة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبي أو وصي، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أنيطت بهم^، كما أخبر بذلك في قوله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)([7])، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقية سير الأنبياء، كما أنّ سيرة الأئمّة^ ليست كبقية سير مسكة االأوصياء السابقين، كما أنّ التفاوت في سير الأئمّة^ فيما بينهم مما لا شك فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقية الأئمّة^.
والإمام الحسين× تلك الشخصية القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة التي دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الربّاني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصية العظيمة التي ملأت أركان الوجود تعلَّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفية والعملية، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمسّ الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قبل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم وأفنوا أغلى أوقاتهم وزهرة أعمارهم لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفية التي تركها× للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفية في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: بل هي أكثر مما تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعددة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤولية المهتمين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق؛ بادرت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكرية والعلمية حول شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى والأساس بمسك هذا الملف التخصصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسية، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميين ـ على شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطة مبرمجة وآلية متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصّين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلمية التخصّصية، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفِّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينية المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصية الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلمية في المؤسسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسَّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلمية في المجال الحسيني، تمّ الوقوف على مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهميته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويات المعتمد في المؤسَّسة تمّ اختيار المشاريع العلمية الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعية للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينية التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلمية وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث المكتوب عن مقتل الإمام الحسين×، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينية). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ ليتمَّ جمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتمُّ استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسَّسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد إخضاعها للتقييم العلمي من قبل اللجنة العلمية في المؤسَّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر تقوم المؤسَّسة بطباعتها.
الثاني: مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية والفقهية والأدبية في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلات العلمية الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلمية الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينية
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونية وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علميّ تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×
وهي موسوعة علمية تخصصية مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون ذلك من خلال جمع كلمات الإمام الحسين× من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية مع بيان لتلك الكلمات، ثمّ وضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام× والواقع العلمي.
الخامس: قسم دائرة معارف الإمام الحسين× أو (الموسوعة الألفبائية الحسينية)
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام وبلدان وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلمية، مكتوبة بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ حديث.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
إنّ العمل في هذا القسم يتمحور حول أمرين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة من قبل اللجنة العلمية في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية، تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
يقوم هذا القسم بمتابعة التراث المكتوب حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة باللغات غير العربية لنقله إلى العربية ومنها إلى لغات أخرى، ويكون ذلك من خلال تأييد صلاحيته للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ترجمته إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينية المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية في شتّى المجالات.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات العلمية
ويتمّ العمل في هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكرية متخصّصة في النهضة الحسينية، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، كما تتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلمية في المؤسَّسة، وكذا سائر الباحثين والمحققين وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينية وفق الأدوات الاستنباطية المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينية التخصصية
وهي مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، وتجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصُّصها.
الحادي عشر: قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصِّص بنشر نتاجات وفعاليات مؤسَّسة وارث الأنبياء، يقوم بنـشر وعرض كتبها ومجلّاتها التي تصدرها، وكذا الندوات والمؤتمرات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسَّسة، ومجمل فعالياتها العلمية والإعلامية.
الثاني عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصِّص وبأقلام علمية نسوية في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبية، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الثالث عشر: القسم الفني
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسَّسة، من خلال برامج إلكترونية متطوِّرة يُشرف عليها كادر فنيّ متخصِّص، يعمل على تصميم الأغلفة وواجهات الصفحات الإلكترونية، وبرمجة الإعلانات المرئية والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها كافّة الأقسام.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.
الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×
تعددت الدراسات وتوالت البحوث وانطلقت الأقلام بلا ملل ولا سأم لتسطر أنواعاً من البحوث وألواناً من المعرفة وأطيافاً من الأحداث بصورة مركّزة مرموقة، ساعيةً في ذلك للكشف عن بعض الجوانب التي اكتنفتها تلك الواقعة العظيمة والأحداث الأليمة في أرض كربلاء التي رجّت الملكوت وهزّت العرش واستنفرت الملائكة، للوقوف على حقيقتها ومدى تأثيرها على تاريخ البشر وسلوك الإنسان، واستخلاص الدروس والعبر؛ لتكون مدرسة نامية حيّة طريّة لتربية الأجيال على طول المسير ومدى العصور، وكلّما تضافرت الجهود وتشاورت العقول كانت النتائج أكثر أهميّة وتأثيراً. ومن هذا المنطلق نحت البحوث والدراسات الحسينية منحى العمل الموسوعي والمشترك، فكانت الموسوعات أسبر غوراً وأكثر نتاجاً وأعظم فائدة.
ولكلام الإمام الحسين× أبعاد وجوانب متميزة تبعاً لما تحمله هذه الشخصية من عظمة وجلالة بدءاً بكونه ابن رسول الله’ وأنّه إمام معصوم وختاماً بكونه ثار الله، فكانت هناك أكثر من موسوعة جمعت كلمات الإمام الحسين× بترتيب موضوعي مجمل دون مزيد من الإمعان وتدقيق في شرح الكلام، وهو وإن كان عملاً كبيراً قد تضمّن استخراج تلك الكلمات من بطون الكتب بشتّى ألوانها ومختلف تصانيفها مع تبويب وتقسيم للكلمات، لكنّه يبقى بحاجة إلى تقييم من جهات عديدة أخرى، فإنّ كلمات المعصوم بحاجة إلى المزيد من البحوث والدراسات والكتب والموسوعات. من هنا قامت مؤسسة وارث الأنبياء بالعمل على تأليف موسوعة حول كلمات الإمام الحسين× تحت عنوان: (الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×)، فكانت كلمات الإمام الحسين× أصلاً وأساساً في هذا العمل مدعومة بالآيات القرآنية والأحاديث المعتبرة المروية عن النبي’ وأهل بيته^، فأضفت التماسك والجمالية واقترنت بالأنوار الإلهيّة، وقد أعطت مساحة واسعة للدراسات المعرفيّة بجهود مضنية وأحدث المعلومات الرصينة في شتّى مجالات العلم والمعرفة الإنسانية والتجريبية، وقد كان تأليفها وتبويبها على عناوين وأبواب كليّة عامّة تتبعها فروع كثيرة في أنواع العلوم الحديثة والقديمة كعلم الكلام والفلسفة والأخلاق وعلم النفس والاجتماع والقانون والفقه وأصوله والفيزياء والكيمياء والطب والهندسة وغيرها من أصناف العلوم، وقد بذلت جهود مضنية لإيجاد الترابط والتناسق بين آلاف المعلومات ومئات المواضيع، فكان العمل بتحقيق علمي وأسلوب جميل وقلم موحّد تحت إشراف هيئة علمية متخصصة، ويعدّ هذا العمل أحد أهم الموسوعات العلمية التي تقوم على إصدارها مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، ضمن مشاريع كبيرة وموسوعات مهمّة تتناول جوانب عديدة من النهضة الحسينية المباركة في دراسات عميقة بوجود كوادر علمية متخصصة.
شكر وثناء
وإذ نثمّن الجهود المبذولة من قبل الإخوة العاملين على هذا المشروع الكبير، نتقدّم بالشكر والامتنان والتقدير للأستاذ الفاضل والمحقق البارع الشيخ علي أصغر الرضواني والأستاذ مهدي الرضواني والدكتور الشيخ عمار الجويبراوي والدكتور الشيخ محمّد الحلفي الذي كان على عاتقه الترجمة، والشيخ عبد الله الخزرجي الذي قام بمهمّة المراجعة وتقويم النصّ، والإخوة في القسم الفني الشيخ حسين المالكي والمهندس السيّد مهدي المعلّمي والمهندس محمّد صادق الرضواني والسيّد صادق الحيدري، وكلّ من ساهم وشارك في إنجاز هذا العمل المبارك.
ونسأل الله تعالى أن يوفّقنا في أعمالنا، إنّه سميع مجيبٌ
اللجنة العلمية في
مؤسسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
نتطرّق في هذا المدخل إلى بعض الموضوعات التي ترتبط ارتباطاً كليّاً أو جزئياً بالموسوعة العلمية لكلمات الإمام الحسين×. وقد تمّ تبويب هذه الموضوعات تحت عناوين مستقلة:
1ـ التقرير المفصّل للموسوعة: من الضروري أن يطّلع القارئ أوّلاً على فهرست الموسوعة لكونها تشتمل على موضوعات متعددة، وإن كان من المحتمل أن تطرأ على هذه الموضوعات بعض التغييرات الكلية أو الجزئية أثناء تدوين مجلدات الموسوعة.
2ـ إمامة الإمام الحسين×: بما أنّ سيّد الشهداء× هو إمام المسلمين وقائدهم، أصبح من الضروري بمكان أن نطّلع على كلماته وخطاباته، إلّا أنّه ينبغي قبل الخوض في كلماتهأن نثبت إمامته أوّلاً، لهذا سنشير تحت هذا العنوان إلى أدلة إمامته×، وسنكتفي من الأدلة القرآنية بذكر آية (أولي الأمر)ومن الأدلة الروائية بحديث «اثني عشر إماماً وخليفة».
3ـ المرجعية الدينية والعلمية للإمام الحسين×: انطلاقاً من كون أحاديث وكلمات المرجع الديني والعلمي حجّة على الإنسان، يجدر بنا أن نثبت المرجعية الدينية والعلمية للإمام الحسين× قبل البحث في أحاديثه، لذا سوف نبحث في الأدلّة القرآنية على مرجعيته× من قبيل آية (التطهير)، (أهل الذكر)، (علم الكتاب)، (الاعتصام)، (مسّ الكتاب)، (أوتوا العلم)، (الاصطفاء). وسنكتفي بالبحث من حيث الدليل الروائي على مرجعيته الدينية والعلمية بحديث الثقلين، والسفينة، والأمان.
كما سنشير إلى الأدلة العقلية والتاريخية لمرجعية الإمام الحسين× الدينية والعلمية من قبيل: سنّة الإمام الحسين× طريق للسنّة النبوية الشريفة، وضرورة حفظ السنّة بواسطة المعصوم نفسه، حاجة الإسلام إلى عصر التطبيق، البحث في الأبعاد التاريخية وضرورة بقاء البُعد التفسيري.
4ـ فضائل الإمام الحسين×: قبل الخوض في بحث خطابات الإمام الحسين× وكلماته، نشير إلى بعض فضائله ومناقبه، كي تتجلى لنا عظمة كلماته، حيث إنّ الإنسان مجبول على الالتفات إلى حديث أصحاب الفضيلة. وسنتطرّق خلال هذا البحث إلى فضائل سيّد الشهداء× الواردة في القرآن الكريم من قبيل آية (المودّة)، و(المباهلة)، و(الإطعام)، وكذا الآية التي تشير إلى قبول التوبة من النبي آدم×، وسوف نفرد بحثاً خاصاً يتناول ولايته التكوينية.
أمّا الروايات التي تشير إلى فضائله× فستكون على أربعة أقسام، فضائل الإمام الحسين× المشتركة مع باقي الأئمّة، وفضائله المشتركة مع أصحاب الكساء، وفضائله المشتركة مع الإمام الحسن×، وفضائله× على وجه الخصوص.
5ـ مصادر علوم الإمام الحسين×: وسنسلّط الضوء تحت هذا العنوان على مصادر علم الإمام الحسين×، من أين أخذت؟ وممّن اكتسبت؟ لأنّ أحاديثه× تجلٍّ لعلمه ومعرفته. وسيقع البحث حول ما يلي: استناده× إلى رسول الله|، كتاب الإمام علي×، مصحف السيّدة فاطمة‘، الإشراقات والإلهامات الغيبية التي كانت تفاض عليه×.
6ـ ضرورة العمل بروايات الإمام الحسين×: بما أنّ أغلب أحاديث الإمام الحسين× وصلتنا على شكل روايات هذا من جانب، وأنّه إمام مفترض الطاعة من جانبٍ آخر، صار حريّ بنا أن نشير في أبحاث المدخل إلى ضرورة الأخذ برواياته والعمل بها. وعليه سنتطرّق إلى أدلّة ضرورة الأخذ بروايات الإمام الحسين× من قبيل وثاقته وعصمته، ورجوع سنّته× إلى السنّة النبوية مع ذكر الأدلة القرآنية على ذلك.
7ـ حجيّة تفسير الإمام الحسين×: بما أنّ بعض كلمات الإمام الحسين× جاءت تفسيراً للآيات القرآنية، ارتأينا أن نتطرّق في المدخل إلى حجيّة تفسير الإمام× مستندين في ذلك إلى بعض البيانات المستلهمة من الآيات القرآنية التي تثبت موضوع حجيّته× في التفسير.
8 ـ أدعية الإمام الحسين×: تحتلّ الأدعية القسم الأكبر مما وردنا عن الإمام الحسين×، وعليه قمنا بفهرسة الأدعية المنسوبة إليه× مع ذكر المصادر والمنابع التي أخذت منها. وقد تطرّقنا تحت هذا العنوان إلى البحث في مفهوم الدعاء وأنواعه، ثمّ أوردنا أدعية الإمام× حسب التفصيل التالي: أدعيته المستقلة، أدعيته الواردة ضمن خطبه، أدعيته في الموارد العامة، أدعيته في الموارد الخاصة، دعاؤه على الأعداء، دعاؤه على بعض الأشخاص، مضافاً إلى ذكرنا لأهمّ وأبرز خصائص أدعية الإمام الحسين×.
9ـ تحقيق في ذيل دعاء عرفة للإمام الحسين×: نتيجة لاختلاف الآراء في نسبة ما ورد في ذيل دعاء عرفة للإمام الحسين× وما يحتويه من مطالب، ارتأينا أن نحقّق في ذيل هذا الدعاء على وجه الخصوص من حيث السند والدلالة، لهذا قمنا بعد ذكر المصادر والآراء المطروحة، ببيان القرائن والأدلة التي أتى بها الموافقون والمخالفون لهذا الدعاء ومناقشتها.
10ـ البحث في قصّة أرينب: نظراً لما جاء من أحاديث كثيرة للإمام× بخصوص هذه القصّة أوّلاً، ولما تحتويه هذه الأحاديث من مناقشات في السند والدلالة ثانياً، ارتأينا أن نبحث ونحقّق في الشبهات الواردة حول هذه القصّة؛ فقمنا ببيان أصل قصّة أرينب، ثمّ تطرّقنا إلى البحث في تسعة عشر إشكالاً وارداً حولها.
11ـ طرق إثبات اعتبار الخبر الواحد: أغلب ما روي عن الإمام الحسين× كان على شكل أحاديث يصعب دراستها وتحقيقها جميعاً من حيث السند، لهذا تمّت في هذا المدخل الإشارة إلى طرق اعتبار أخبار الآحاد، حيث سنعتمد في سلسلة البحوث اللاحقة من المجلدات القادمة لهذه الموسوعة أحد هذه الطرق ألا وهو طريق التأييد المضموني.
وفي الختام:
أحمد الله حمداً لا ينفد أوّله ولا ينقطع آخره، وأشكره سبحانه وتعالى على آلائه وتفضّله عليّ بأن هيّأ لي هذه الفرصة ووفّقني لأصبح من المهتمّين بالأحاديث الحسينية، متأمّلاً فيها مستكشفاً منها ما تضمّنته من إشارات ولطائف، وأتوصّل من خلالها إلى معان ومفاهيم أنتفع بها أوّلاً، وتؤهّل قابلياتي وترفع من قدراتي على إنتاج العلوم واستخراج الدرر من ثنايا تلك الأحاديث على أصعدة مختلفة ومستويات متعددة، وجعلها متاحة بين يدي المجتمعات المتعطّشة لها ثانياً. وما أعظمها من منحة ربّانية أن يقتات الإنسان على مائدة أبي الأحرار المعنوية، بما يعجز عن أداء شكره اللامتناهي.
كما وأرفع أسمى التحيّات إلى الروح الطاهرة لصاحب النفس المطمئنة (الإمام الحسين×) وأسلّم عليه أبلغ سلام، وأشكره؛ إذ منّ عليّ بالدنو من حريم كلامه النيّر وشرحه وبيانه، حيث ليس من الممكن الدخول لهذا الحريم المقدّس دون الاتّصاف بالإخلاص ونقاء الباطن والظاهر: (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)([8]).
ولا يفوتني إبداء شكري الوافر من منطلق: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْمـُنْعِمَ مِنَ المخْلُوقِينَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ» لسماحة الشيخ المبجّل عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدّسة، والشيخ باقر الساعدي مدير مؤسسة وارث الأنبياء في النجف الأشرف، والشيخ رافد التميمي مدير المؤسسة في مدينة قم المقدّسة، ومعاونه الشيخ حيدر الأسدي، وجميع الزملاء الأعضاء في كلتا المدينتين المقدّستين، وأتمنّى من الله أن يجعلهم جميعاً من المشمولين بألطاف سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين× وكرمه.
وأخيراً أتقدّم بالشكر لأولئك الذين كان لهم إسهام وافر وحصّة كبيرة في مساعدتي بصورة مباشرة من أجل إنجاح عملي العلمي هذا، وهم: الدكتور عمار الجويبراوي، والدكتور الشيخ محمّد الحلفي، والأستاذ مهدي الرضواني، والمهندس محمّد صادق الرضواني. وأسأل من الله العلي القدير أن يحوطنا بتوفيقه لمواصلة هذا النتاج العلمي وإكماله بأحسن نحو وأبهى صورة، وينال رضى الله} ورضى وليّه سيّد الشهداء×.
علي أصغر الرضواني
نحمده تعالى ونثني عليه على ما تفضّل علينا من نعمةٍ بالغة ألا وهي العمل على تمهيد الأرضية المناسبة لتقدّم العلم والثقافة، حيث منّ سبحانه على المحققين بالبحث والتدوين ـ سواء بصورة فردية أو جماعية ـ حتى أُصدرت في الآونة الأخيرة بحوثٌ قيّمة في مجالات مختلفة من جملتها ما كان يرتبط بأهل بيت العصمة والطهارة بما فيهم الإمام الحسين×، فكان من بين تلك المشاريع البحثيّة تدوين الموسوعات المختلفة ذات المناهج المتنوّعة، واستحق سعي الجميع في هذا المجال الثناء والتبجيل.
ومواكبةً للمشاريع البحثيّة قامت مؤسسة وارث الأنبياء× التابعة للعتبة الحسينية المقدّسة بتدوين موسوعة في شرح أحاديث الإمام الحسين× أعمّ من أدعيته وخطبه ورواياته.
إنّ مصادر استنباط الحكم الشرعي عند الشيعة عبارة عن القرآن، السنّة، العقل، والإجماع. لكن السنّة التي تتمتّع بمقام العصمة عندنا لم تقتصر على السنّة النبوية فحسب وإنّما تشمل سنّة أهل بيت العصمة والطهارة أيضاً بما فيهم سيّد الشهداء×، ولذا فإنّنا على اعتقاد بأنّ حجيّة سنّة أهل البيت^ بعد النبي| أمر عقلائي وضروري للغاية؛ وذلك لأنّ دين الإسلام هو الدين الخاتم للأديان السماوية وأنّ رسوله هو الرسول الخاتم للرسل الإلهية. ورغم أنّ النبي| قد بُعث في فترة زمنية محدودة إلّا أنّنا نعتقد بجامعيّة وشموليّة رسالته وقابليتها في تغطية كل مجالات الحياة أعمّ من تربية المجتمع البشري وهدايته إلى يوم القيامة. وعليه لا بدّ من وجود أفراد معصومين بعد النبي|، يقومون بتبيين وتطبيق التعاليم القرآنية والسنّة النبوية بالصورة الصحيحة، ويبيّنون طريق الحق والحقيقة للمجتمع الإسلامي عند الاختلاف. وكما أنّ مؤسس الدين وصاحب الرسالة لا بدّ وأن يتمتّع بمقام العصمة كذلك الخلفاء الذين يتلونه يجب أن يكونوا معصومين أيضاً كي يأخذوا بزمام الأمور وتبيينها وتطبيقها بالصورة الصحيحة حتّى تظهر حقيقة أحكام الإسلام ومعارفه للناس. ولذا أكّدت الآيات والروايات من قبيل آية التطهير، وحديث السفينة ومدينة العلم وغيرها على مسألة عصمة الأئمّة^ وأهمية مرجعيتهم الدينية والعلمية وحجيّة سنّتهم، وسيأتي البحث في ذلك مفصّلاً.
إنّ سنّة المعصوم× حجّة على عموم البشر كما هو كلام الله تعالى، وهي على ثلاثة أقسام:
1ـ قول المعصوم.
2ـ فعل المعصوم.
3ـ تقرير المعصوم.
ويمكن الانتفاع من سنّة الإمام الحسين× ضمن الأقسام الثلاثة وتأليف الكتب بشأنها، وقد قمنا في هذه الموسوعة بتدوين سنّته× في القول وتبويبها بصورةٍ خاصة، وإن كان من الضروري أيضاً تدوين موسوعة أخرى في سيرته العمليّة على الخصوص كي تكون ملبّيةً لمتطلّبات الحياة الطيبة والمبتغاة للمجتمع البشري.
الغفلة عن التراث العلمي للإمام الحسين×
الظاهر أنّ غلبة الجانب الثوري للإمام الحسين× أدّى إلى غفلة الكثير وخاصة غير الشيعة عن تراثه العلمي وما ينسب إليه من أحاديث، ولذا فإنّ البحث عن عظمة الإمام الحسين× اقتصر على دراسة ثورته وتحليلها، في حين ينبغي أن لا تكون عظمة ثورته مانعاً عن الوصول إلى تراثه العلمي وأحاديثه المباركة، وهذا ما جعلنا نقوم بتدوين هذه الموسوعة كي نوصل أحاديث الإمام الحسين× وتراثه العلمي إلى عامة الناس.
ضرورة البحث في أحاديث الإمام الحسين×
بالرجوع إلى تاريخ أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين× نجد أنّ سيرتهم قد دوّنت بنحوٍ أو بآخر من حيث القول أو الفعل أو التقرير، هذا من جانب، ومن جانب آخر إنّنا نعلم أنّ الأمّة تحيى بقادتها وأسوتها، وكلما كانت القدوات أرقى وأكمل كان التطوّر أفضل؛ سواء في المجالات المادية أو المعنوية. وبما أنّ أهل بيت النبي| هم أئمة هذه الأمّة من بعده، وأنّهم أفضل قدوة للمجتمع الإسلامي بل للمجتمع البشري أجمع، لذا من الضروري أن يتمّ تبويب أحاديثهم وشرحها بطريقةٍ ونمطٍ خاص وجعلها بين يدي المجتمع بمختلف أقشاره، وهذا ما دفعنا إلى تدوين هذه الموسوعة في أحاديث القدوة المثلى للبشرية، ألا وهو سبط رسول الرحمة الإمام الحسين×.
ضرورة توظيف العاطفة لتحقيق عقلانيّة المجتمع
إنّ ما قام به الإمام الحسين× من إنجازٍ عظيم يوم عاشوراء قد جذب شجا القلوب وخوالجها نحوه، ولذا ينبغي على الخطباء الأفاضل أن يوظّفوا هذه العواطف لهداية المجتمع نحو المعارف الإلهية الحقّة التي ما نهض الإمام الحسين× إلّا لأجل إحيائها، فجدير بأهل المنابر إذن أن يبثّوا أحاديث الإمام الحسين× ليسيروا بالمجتمع البشري نحو العقلانية، خاصة وأنّ مدرسة سيّد الشهداء× ثريّة بالأحاسيس والعقلانية السامية.
ضرورة عرض تراث أهل البيت ^ العلمي
يتمتّع أهل البيت^ بمكانةٍ رفيعة في الأمّة الإسلامية بللدىأتباع الأديان الأخرى أيضاً، كما أنّ سيرتهم الزاخرة بالخير والصلاح لفتت أنظار علماء البشرية إليهم فاتّخذوهم قدوةً وأسوةً لهم. ومع ذلك قد يسأل سائل بعد التعريف بتلك الذوات المقدّسة عمّا تركوه من ميراثٍ علمي يمكن للقارئ بعد المطالعة والتأمّل فيه من الانتفاع به في صياغة الحياة المطلوبة، وهذا ما يُلقي المسؤولية والتكليف الأكبر على عاتق المؤسسات الدينية والمؤلّفين كي يشمّروا عن سواعدهم في نشر وبسط التراث العلمي لأهل البيت^ بما فيهم سيّد الشهداء×.
إنّ أكثر الأئمّة المعصومين من ذريّة رسول الله| عاشوا في زمن لم يسمح لهم الأعداء بنشر معارفهم الحقّة، ولم يتجرّأ أصحابهم على القيام بهذه المهمّة؛ كي تصل تلك المعارف إلى الأجيال، ولم تُستثنَ حياة الإمام الحسين× من هذا الاختناق السياسي، فما وصلنا من أحاديث عنه× يتعلّق أكثرها بأواخر حياته وخاصة السنة الأخيرة من عمره الشريف، وبالرغم من ذلك فإنّ ما وصلنا من النزر اليسير يدلّ على عظمة علمه وغزارة معرفته، وأنّ هذا المقدار اليسير من تراثه العملي بإمكانه أن يكون منهجاً للإنسانية في جميع مجالات الحياة للحصول على سعادة الدنيا والآخرة.
ضرورة التجديد والابتكار في التحقيق
لقد أُنجزت في الآونة الأخيرة مشاريع قيّمة في مجال البحوث والدراسات في الحوزات ومراكز الأبحاث العلمية كان لكل منها إبداع خاص جدير بالشكر والتقدير، وما امتازت به هذه الموسوعة من الابتكار وجعلته نصب عينها هو إنتاج العلوم الإسلامية ـ الإنسانية في المجالات المختلفة وتطويرها، حيث حاولنا استخراج ذلك من الأحاديث المنسوبة لسيّد الشهداء× والتأمّل فيها وشرحها بالشكل المطلوب.
جاء ترتيب هذه الموسوعة التي ضمّت الآلاف من الموضوعات والملاحظات المختلفة بالصورة التالية: بيان الموضوع بشكلٍ عام في صفحة مستقلّة، ثمّ الإشارة إلى المسائل المتفرّعة على ذلك الموضوع في أوّل الصفحة، وبعدها الإتيان بأحاديث الإمام الحسين× وشرحها بصورة مختصرة، ثمّ الإلفات إلى الإشارات واللطائف المستوحاة من الحديث ودعمها بآية أو حديث أو دعاء، وشرح المفردات في الحديث ـ إن استدعى الأمر ـ والاستفادة من كلام العلماء والمفسرين في بعض الأحيان.
تمّ بحوله تعالى تدوين وإصدار هذه الموسوعة بلغتين، العربية والفارسية في وقت واحد.
تتمتّع هذه الموسوعة بخصائص، وهي عبارة عن:
1ـاستقصاء وبحث أحاديث الإمام الحسين× في المصادر الشيعية والسنّية والزيدية، وقد تمّ مطالعة العديد من الكتب في هذا المجال لاستخراج كلمات الإمام× منها.
2ـتختلف هذه الموسوعة عن باقي الموسوعات التي تُعنى بكلمات وأحاديث الإمام الحسين× بأنّها يتمّ فيها أحياناً الإتيان برواية مفصّلة أو روايات عديدة تحت عنوان واحد، من قبيل ما جاء في (كتاب الدعاء) حيث ذكر فيه دعاء عرفة وباقي الأدعية المنسوبة للإمام الحسين×، وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نشرح بدقّة كلّ رواية ودعاء حسب العبارات الواردة فيها كي نستخرج منها الملاحظات والموضوعات، ولذا قمنا في دعاء عرفة ـ على سبيل المثال ـ باستخراج الآلاف من الموضوعات والملاحظات المختلفة التي ترتبط بشتّى العلوم.
3ـ من خصوصيات هذه الموسوعة وميزاتها الإشارة إلى الملاحظة أو الموضوع وبيان طريقة استخراجه من الحديث الذي جاء تحت عنوان شرح كلام الإمام×.
4ـمن الخصوصيات الأخرى لهذه الموسوعة العلمية تأييد مضمون النكات والإشارات المستخرجة من أحاديث الإمام الحسين× بالآيات والروايات والأدعية وشرحها بالاستفادة من عبارات العلماء.
5ـمن ميزات هذه الموسوعة العلميةسعة العناوين الكلية والمتفرّعة منها والتي سيتمّ الإشارة إليها في محلها.
6ـحاولنا في هذه الموسوعة مراعاة الترتيب المنطقي في العناوينالفرعية الواردة تحت العنوان الكلي وترتيبها في هيكلية علمية قدر الإمكان، فعلى سبيل المثال هناك إشارات عديدة لسيّد الشهداء× في مواضع متعددة تشير إلى أهداف ثورته، تمّ جمعها في مكان واحد تحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين×.
7ـمقارنة العناوين المستلهمة من أحاديث سيّد الشهداء× مع العلوم التخصّصية الحديثة، ولذا سيتمّ عرض كل كتاب بعد إتمامه على متخصصي الفن أو العلم المعيّن حتّى يدلوا بآرائهم ووجهات نظرهم حوله.
8ـعدم الإطناب ـ قدر الإمكان ـ في شرح الحديث للحيلولة دون ملل القارئ، ولذا اكتفينا بالاختصار في قسم التأييد المضموني.
9ـ إرجاع كل حديثٍ إلى مصادره الأوّليّة وعدم الاكتفاء بأخذه من المصادر المتأخّرة، وذلك احترازاً من وجود الخلل في نقل الحديث بعض الأحيان.
10ـ الحيلولة دون حدوث الخلل في الحديث بعد تقطيعه، فإن كان أوّل الحديث يرتبط بآخره، أتينا به بأجمعه؛ لأنّ تقطيعه يوجب الإخلال به.
11ـ الجمع المنطقي بين أحاديث الإمام الحسين× وأحاديث الأئمّة المعصومين^، ورفع التعارض البدوي ـ إن وجد ـ بالجمع العرفي والعقلائي.
12ـ الإتيان بجميع الرواية من دون حذف، مع التوجيه العقلائي لما يخالف عقائد الشيعة القطعية بالظاهر، بخلاف ما يصنعه بعض المؤلّفين من حذف الكلمات التي لا تنسجم مع عقائد الشيعة.
13ـ أخذ أحاديث الإمام الحسين× من الكتب المعتمد عليها عند العلماء، والامتناع عن نقل الأحاديث من الكتب التي تحتوي على الأحاديث الشاذّة المنسوبة إليه×.
14ـ الاقتصار على ذكر وشرح أحاديث الإمام الحسين× بالذات والتي يصدق عليها عبارة «قال الحسين×»، بخلاف ما ذكرته باقي الموسوعات من مسانيد الإمام الحسين× وما نقله عن الرسول| أو عن الإمام علي× أو عن السيّدة الزهراء‘ أو عن الإمام الحسن×، وإدراجه تحت أحاديث سيّد الشهداء× في حين أنّها أحاديث لتلك الذوات المقدّسة.
15ـ السعي لتوثيق الأدعية الواردة عن الإمام الحسين×، وإبداء الرأي المختار في الأدعية المختلف في سندها بعد البحث المفصّل فيها، من قبيل «ذيل دعاء عرفة».
16ـ الاكتفاء بالإشارة إلى الملاحظة أو النقطة المهمّة في الحديث التي ترتبط بالباب أو الموضوع المعيّن، وأمّا النقاط والملاحظات الأخرى فتتمّ الإشارة إلى تكرّرها في الأبواب أو المواضيع الأخرى.
تناولت الموسوعة عناوين عامّة تفرّعت عنها عناوين جزئية تمّ اقتباسها من أحاديث الإمام الحسين×، وقد تمّ ترتيب هذه العناوين بصورة منطقية بحيث يمكننا أن نفرد لكل عنوان منها مجلداً خاصاً. وأمّا الأبحاث القصيرة فتمّ دمجها مع ما يناسبها من العناوين الأخر، كما جاء في بحث الفقه والأصول، وإثبات وجود الله ومعرفته وغيرها. وها نحن نشير إلى العناوين العامة للموسوعة وما يتفرّع منها، ولا يفوتنا أن نذكّر بإمكانية حدوث التغيير في بعضها لاحقاً:
تطرّق المدخل إلى بعض الأبحاث التمهيدية حول الإمام الحسين× مما له نوعاً من الارتباط بهذه الموسوعة من قبيل:
أ) نظرة تفصيليّة عن الموسوعة.
ب) إمامة الإمام الحسين×:
1ـ آية (أولي الأمر).
2ـ أحاديث اثني عشر إماماً وخليفة.
ج) المرجعية الدينية والعلمية للإمام الحسين×:
1ـ آية (التطهير).
2ـ آية (أهل الذكر).
3ـ آية (علم الكتاب).
4ـ آية (الاعتصام).
5ـ آية (مسّ الكتاب).
6ـ آية (أوتوا العلم).
7ـ آية (الاصطفاء).
8ـ حديث الثقلين.
9ـ حديث السفينة.
10ـ حديث الأمان.
11ـ سنّة الإمام الحسين× طريق للسنّة النبوية.
12ـ ضرورة حفظ السنّة بواسطة المعصوم.
13ـ حاجة الإسلام لعصر التطبيق.
14ـ دراسة الأبعاد التاريخية.
15ـ ضرورة استمرار عنصر التبيين بواسطة المعصوم.
د) فضائل الإمام الحسين×:
1ـ آية (المودّة).
2ـ آية (المباهلة).
3ـ آية (الإطعام).
4ـ آية (قبول توبة آدم×).
5ـ الولاية التكوينية للإمام الحسين×.
6ـ الفضائل المشتركة مع الأئمّة الآخرين.
7ـ الفضائل المشتركة مع أصحاب الكساء.
8ـ الفضائل المشتركة بين الإمامين الحسن والحسين÷.
9ـ الفضائل الخاصة بالإمام الحسين×.
ﻫ) مصادر علوم الإمام الحسين×.
و) ضرورة العمل بروايات الإمام الحسين×.
ز) حجيّة تفسير الإمام الحسين×.
ح) أدعية الإمام الحسين×
ط) دراسة حول ذيل دعاء الإمام الحسين× يوم عرفة.
ي) مناقشة قصّة أرينب.
ك) طرق إثبات اعتبار خبر الآحاد.
المعرفة علم يبحث عن حقيقة معرفة الإنسان وقيمتها وعواملها وأسبابها ودرجاتها وأنواعها وآثارها وموانعها، وهو من العلوم التي أثارت اهتمام علماء الغرب في القرون المتأخرة، فبحثوا فيه كثيراً وأعطوه صبغة العلم المستقل عن باقي العلوم. لكننا بالرجوع إلى التراث الإسلامي الروائي وخاصة إلى روايات أهل البيت^ ومنهم الإمام الحسين×، نجدها قد تطرّقت إلى ما يتعلّق بهذا العلم بصورة واسعة، ولذا بحثنا في هذه الموسوعة المواضيع التالية:
1ـ المعرفة.
2ـ المعارف الإلهية.
3ـ مصادر المعرفة وأدواتها:
أ) الوحي.
ب) الإلهام.
ج) العقل.
د) الحكمة.
ﻫ) التجربة.
و) التاريخ.
ز) الفطرة.
ح) الكشف.
ط) الطبيعة.
ي) الحس.
ك) الهداية.
ل) التفكّر.
م) البصيرة.
ن) تزكية النفس.
4ـ درجات المعرفة:
أ) العلم.
ب) اليقين.
5ـ المؤهّلات للمعرفة:
أ) التقوى.
ب) الإيمان.
6ـ أنواع المعرفة.
7ـ آثار المعرفة.
8 ـ طرق المعرفة.
9ـ الموانع العملية للمعرفة:
أ) اتّباع الهوى.
ب) الجهل.
ج) الشكّ والشبهة.
د) الذنب.
ﻫ) الوهم.
و) السفاهة.
ز) الضلال.
ح) الغفلة.
ط) حبّ الدنيا.
10ـ الموانع النظرية للمعرفة:
أ) إمكان معرفة الحق.
ب) الهرمنيوطيقا.
ج) التعدّدية الدينيّة.
د) التعدّدية المذهبيّة.
من الأبحاث التي تناولتها أحاديث سيّد الشهداء× مباحث الإيمان والإسلام والكفر والنفاق وما يلازمها، لذا كانت هذه المواضيع في صدارة المباحث التي تمّ استخراجها من روايات الإمام الحسين× تحت هذه العناوين:
أ) الإسلام:
1ـ ما يتعلّق به الإسلام.
2ـ شريعة الإسلام.
3ـ أنواع الإسلام.
4ـ آثار الإسلام.
5ـ أوّل من أسلم من النساء.
6ـ وظائف المسلمين.
7ـ الأمّة الإسلامية.
8ـ أسباب اندراس الإسلام.
9ـ من حقوق المسلمين.
10ـ من رجالات صدر الإسلام (أمير المؤمنين×).
11ـ حكم المسلمين.
12ـ الفرق بين المؤمن والمسلم.
13ـ من خصوصيات الإسلام.
14ـ المرقة من المسلمين.
ب) الإيمان:
1ـ حقيقة الإيمان.
2ـ درجات الإيمان.
3ـ ما يتعلّق به الإيمان.
4ـ ضرورة الانسجام بين الإيمان والإسلام.
5ـ آثار الإيمان.
6ـ آثار الإيمان اليقيني.
7ـ وظائف المؤمنين.
8ـ علاقة العمل بالإيمان.
9ـ قيمة السبق إلى الإيمان.
10ـ أسباب الإيمان.
11ـ من خصوصيات المؤمن.
12ـ العلاقة بين الإسلام والإيمان.
13ـ قيمة الإيمان.
14ـ من علائم الإيمان.
15ـ من شروط الانتفاع من الإيمان.
16ـ المؤمن الحقيقي.
17ـ كيفية التنافس بين المؤمنين.
18ـ وظائفنا تجاه المؤمنين.
19ـ وظائفنا تجاه إيمان الأطفال.
20ـ الفرق بين الإيمان واليقين.
21ـ أهل البيت^ علائم الإيمان
ج) الكفر:
1ـ آثار الكفر.
2ـ أسباب الكفر.
3ـ إمكان النجاة من الكفر.
4ـ الحدّ بين الإيمان والكفر.
5ـ أنواع الكفر.
6ـ مفاسد الكفر.
7ـ قادة الكفر.
8ـ إمكان وقوع الكفر بعد الإيمان.
9ـ العقائد الكفرية.
10ـ صفات الكفر.
11ـ أنواع الكافر.
12ـ من أسباب الكفر.
13ـ أحكام الكافر.
14ـ خصائص الكفار.
د) التكفير.
ﻫ) النفاق:
1ـ النفاق والمنافق.
2ـ من علائم النفاق.
3ـ وظائفنا تجاه المنافق.
4ـ من أنواع النفاق
و) العنف.
يحتلّ البحث عن وجود الله موقع الصدارة في المباحث العقدية غالباً؛ لأنّه الحجر الأساس في بناء الرؤية الكونية التي تحدّد سعادة الفرد أو شقاوته، وقد وردت عن سيّد الشهداء× روايات زاخرة بالأدلّة على وجوده تعالى مما دفعنا لفتح بابٍ لها في هذه الموسوعة تحت العناوين التالية:
أ) طريق الشهود والكشف الوجداني.
ب) برهان الفطرة.
ج) البراهين العقلية.
1ـ برهان الوجوب والإمكان.
2ـ برهان حدوث المادة.
3ـ برهان الحركة.
4ـ برهان النظم.
5ـ برهان الهداية.
6ـ برهان الوجود الفقري.
7ـ برهان الصديقين.
8ـ برهان المعجزة.
9ـ برهان العليّة (الأثرية).
10ـ برهان التكامل.
11ـ برهان الفسخ والنقض.
12ـ برهان المحدودية وصرف الوجود.
13ـ برهان الإلجاء والتسخير.
تتمتّع مباحث التوحيد بمكانة خاصة في الآيات والروايات، وبما أنّ أحاديث الإمام الحسين× قد تطرّقت إلى التوحيد، ارتأينا أن نبحث فيه بصورةٍ مستقلة تحت العناوين التالية:
1ـ أهمية التوحيد.
2ـ أنواع التوحيد.
3ـ آثار كلمة التوحيد.
4ـ التوحيد النظري الذاتي.
5ـ التوحيد العملي.
6ـ التوحيد العبادي.
7ـ التوحيد الأفعالي:
أ) التوحيد في الحاكمية
ب) التوحيد في البركة
ج) التوحيد في الربوبية
د) التوحيد في الخالقية
8ـ وظيفتنا تجاه التوحيد.
9ـ طائفة الموحدين.
تتمتّع مباحث الشرك بمكانة خاصة في الآيات والروايات إلى درجة أنّها عدّت الشرك بأنّه أعظم الذنوب الكبيرة ولا يمكن غفرانه إلّا بالتوبة منه والعود إلى التوحيد، كما لوحظ في القرون المتأخرة من تكفير الوهابية لمخالفيهم ورميهم بالشرك والحكم عليهم بالقتل. وبما أنّ أحاديث الإمام الحسين× قد تطرّقت إلى الشرك، ارتأينا أن نبحث فيه بصورةٍ مستقلة تحت العناوين التالية:
1ـ إله بلا شريك.
2ـ أنواع الشرك.
3ـ آثار الشرك.
4ـ جزاء الشرك.
5ـ استحالة الشرك.
6ـ وظائف الإنسان تجاه الشرك.
7ـ النظريات المشوبةبالشرك.
8ـ من المشركين.
9ـ من موارد الاختلاف في الشرك: (نظام الواسطة).
10ـ من موارد الاختلاف في الشرك: (التوسّل):
أ) جواز التوسّل.
ب) أنواع التوسّل.
ج) شروط التوسّل.
11ـ من موارد الاختلاف في الشرك: (الاستغاثة بأرواح الأولياء).
12ـ من موارد الاختلاف في الشرك: (طلب الشفاعة من أرواح الأولياء).
13ـ من موارد الاختلاف في الشرك: (النداء لأرواح الأولياء).
7 ـ الصفات الثبوتية للّه تعالى
نتطرّق في هذا الفصل إلى بعض الموضوعات المرتبطة بالصفات الثبوتية الذاتية لله تعالى، مع الإتيان بشواهد من أحاديث الإمام الحسين× وخطاباته وأدعيته. هذه الموضوعات والصفات عبارة عن:
1ـ معرفة الله.
2ـ العلم الإلهي.
3ـ القدرة.
4ـ الحياة.
5ـ السمع.
6ـ البصر.
7ـ الخبير.
8ـ الإدراك.
9ـ الأزليّة.
10ـ الأبديّة.
11ـ الغناء.
12ـ اللطف.
13ـ القيوميّة.
14ـ الألوهيّة.
15ـ البقاء.
16ـ الهيبة.
17ـ البهاء.
18ـ الجبروت.
19ـ التعالي.
20ـ الصمد.
21ـ العزّة.
22ـ الدوام.
23ـ الكبرياء.
24ـ الملكيّة.
25ـ العظمة.
26ـ الجلالة.
27ـ الظهور.
28ـ الحميد.
29ـ القدّوس.
30ـ الحق.
31ـ السبّوح.
32ـ الرفعة.
33ـ المجد.
34ـ القدم.
35ـ الحضور.
36ـ القهر.
37ـ العرفان.
38ـ الحول والقوّة.
39ـ السيادة.
نتطرّق في هذا الفصل إلى الموضوعات المرتبطة بالصفات السلبية لله تعالى مستندين في كلٍ منها إلى أحاديث سيّد الشهداء× وخطاباته وأدعيته. هذه الموضوعات والصفات السلبية عبارة عن:
1ـ الصفات السلبية.
2ـ لوازم الصفات السلبية.
3ـ التنزيه الإلهي.
4ـ التجرّد.
5ـ النظير.
6ـ الشبيه.
7ـ البنوّة.
8ـ ولاية الغير.
9ـ الذلّة.
10ـ الضدّ.
11ـ المعين.
12ـ الولادة.
13ـ الرؤية.
14ـ الحاجة.
15ـ الإدراك.
16ـ الحدّ.
17ـ الثناء.
18ـ الخفاء.
19ـ الغَيبة.
20ـ المغلوبيّة.
21ـ الحجاب.
22ـ الغفلة.
23ـ العجز.
24ـ خلف الوعد.
25ـ الخوف.
26ـ السرور.
27ـ النوم.
28ـ السِنَة.
29ـ الجسم.
30ـ الكفؤ.
31ـ السميّ.
32ـ المثل.
33ـ الابتلاء.
34ـ التغيير.
35ـ محل الحوادث.
36ـ الوصف.
37ـ العِدل.
38ـ الحدوث.
39ـ الجهة.
40ـ الحلول.
41ـ المشاور.
42ـ العلّة.
43ـ الأكل والشرب.
44ـ النقص.
45ـ الاستكمال الذاتي.
46ـ النسيان.
47ـ الإدانة.
48ـ الوريث.
49ـ النسيان.
50ـ الخواطر.
51ـ الهمّ والغمّ.
52ـ الحزن.
53ـ الفرح.
54ـ البكاء.
55ـ الأمل.
56ـ الرغبة.
57ـ التعب.
58ـ الجوع.
59ـ الشبع.
60ـ التركيب.
المراد بالصفات الخبرية، الصفات الثابتة لله تعالى التي أشير إليها في الآيات والروايات، والتي وقع الخلاف في تفسيرها، وقد ذكرها الإمام الحسين× في رواياته، لذا سنعقد لها فصلاً خاصاً تحت العناوين التالية:
أ) التأويل عند الإمام الحسين×.
ب) نماذج من تأويلات الإمام الحسين×:
1ـ البُعد الإلهي.
2ـ القرب الإلهي.
3ـ مجيء الله.
4ـ العلو الإلهي.
5ـ العين الإلهية.
6ـ وجود الله في الأشياء.
7ـ مقارنة الله للأشياء.
ج) الصفات الخبرية في كلمات الإمام الحسين×:
1ـ الوجه الإلهي.
2ـ نور وجه الله.
3ـ النور الإلهي.
4ـ العرش الإلهي.
5ـ الكرسيّ الإلهي.
6ـ الذات الإلهية.
7ـ الكنز الإلهي.
8ـ الخزائن الإلهية.
9ـ الركن الإلهي.
10ـ الكنف الإلهي.
11ـ الباب الإلهي.
12ـ أيام الله تعالى.
13ـ الغضب الإلهي.
14ـ الحب الإلهي.
15ـ السلام الإلهي.
16ـ البيت الإلهي.
17ـ الكلمات الإلهية.
18ـ الكتابة الإلهية.
19ـ الحجاب الإلهي.
20ـ السمع الإلهي.
21ـ البصر الإلهي.
22ـ الرؤية الإلهية.
23ـ الاستقراض الإلهي.
24ـ المراقبة الإلهية.
25ـ الإمساك الإلهي.
26ـ الرأفة الإلهية.
27ـ الحلم الإلهي.
28ـ الخلق الإلهي.
29ـ السعادة والشقاوة الإلهيان.
30ـ القضاء الإلهي.
31ـ الإرادة والمشيّة الإلهية.
32ـ الإضلال الإلهي.
33ـ المكر الإلهي.
34ـ الخدعة الإلهية.
35ـ الخذلان الإلهي.
36ـ الحضور الإلهي.
37ـ الرضا الإلهي.
38ـ الاستعراض الإلهي.
جاء في أدعية سيّد الشهداء× الكثير من أسماء الله تعالى وصفاته الفعلية سواء بصورة نداء أو خطاب، ولذا تناولنا في هذا الفصل جميع تلك الأسماء والصفات ثمّ شرحها وتوضيحها.
أ) مباحث تمهيدية مرتبطة بالأسماء الإلهية:
1ـ أزليّة وصف الله بالأسماء والصفات.
2ـ سرّ الاسم الإلهي المحفوظ.
3ـ تنزيه الأسماء الإلهية.
4ـ حسن الطلب من الله بالأسماء الإلهية.
5ـ الأسماء التي رُفعت بها السماوات.
6ـ تجلّي الأسماء الإلهية بأفعاله سبحانه.
7ـ جريان المياه من الله بأسمائه.
8 ـ اسم الله الأعظم.
9ـ علاقة الحروف المقطّعة في القرآن باسم الله الأعظم.
ب) مباحث تمهيدية مرتبطة بالأفعال الإلهية:
1ـ تناسب كلّ فعل إلهي مع صفاته.
2ـ تأثير فعل الله في الأمور الجزئية.
3ـ أحياناً السبب أقوى من المباشر.
4ـ نوعية الأفعال الإلهية.
5ـ حسن نداء الله بأفعاله.
6ـ الله هو المسبّب.
7ـ الله تعالى مرجع الحاجات.
8 ـ نظام الأسباب والمسبّبات في العالم.
9ـ وظيفة المتمسّكين بالأسباب.
10ـ تأثير الصفات الذاتية الإلهية في أفعاله تعالى.
11ـ هدفيّة الأفعال الإلهية.
12ـ من أهداف خلق العالم.
13ـ الهدف من خلق الإنسان.
14ـ من صفات الفعل الإلهي.
15ـ نحو تأثير الصفات الفعلية في الأفعال الإلهية.
16ـ جواز نسبة الفعل للمسبّب والمباشر في نفس الوقت.
17ـ الأمور اللائقة بالله تعالى.
18ـ التدابير الإلهية في نظام الأسباب والمسبّبات.
19ـ حكم وكيفية الأفعال الإلهية.
ج) الأفعال الإلهية:
1ـ العطاء الإلهي.
2ـ الصنع الإلهي.
3ـ الجود الإلهي.
4ـ الخلق الإلهي.
5ـ العدل الإلهي.
6ـ الهداية الإلهية.
7ـ المدد الإلهي.
8ـ النعم الإلهية.
9ـ الرحمة الإلهية.
10ـ الربوبية الإلهية.
11ـ اللطف الإلهي.
12ـ الرأفة الإلهية.
13ـ الإحسان الإلهي.
14ـ الرزق الإلهي.
15ـ المنّة الإلهية.
16ـ الرضا الإلهي.
17ـ التوفيق الإلهي.
18ـ الشكر الإلهي.
19ـ الولاية الإلهية.
20ـ السلام الإلهي.
21ـ العافية الإلهية.
22ـ الإطعام الإلهي.
23ـ الإغناء الإلهي.
24ـ الإرضاء الإلهي.
25ـ الكفاية الإلهية.
26ـ الإخلاف الإلهي.
27ـ الوكالة الإلهية.
28ـ البركة الإلهية.
29ـ الغضب الإلهي.
30ـ الأمان الإلهي.
31ـ الفضل الإلهي.
32ـ الكرم الإلهي.
33ـ القهر الإلهي.
34ـ العناية الإلهية.
35ـ المشيئة الإلهية.
36ـ المغفرة الإلهية.
37ـ العفو الإلهي.
38ـ الحلم الإلهي.
39ـ الثواب الإلهي.
40ـ العطف الإلهي.
41ـ الهبة الإلهية.
42ـ المكر الإلهي.
43ـ الكفالة الإلهية.
44ـ النصرة الإلهية.
45ـ الإشراق الإلهي.
46ـ العزّة الإلهية.
47ـ العقوبة الإلهية.
48ـ الوعد الإلهي.
49ـ الكلام الإلهي.
50ـ الانتقام الإلهي.
51ـ التطهير الإلهي.
52ـ الصيانة الإلهية.
53ـ التسديد الإلهي.
54ـ الخذلان الإلهي.
55ـ الحرز الإلهي.
56ـ الحول والقوّة الإلهيين.
57ـ المراقبة الإلهية.
58ـ الابتلاء الإلهي.
59ـ الكفاية الإلهية.
60ـ الحاكمية الإلهية.
61ـ الكرامة الإلهية.
62ـ الحسنات الإلهية.
63ـ الحراسة الإلهية.
64ـ الإهانة الإلهية.
65ـ الأمان الإلهي.
66ـ الشأن الإلهي.
67ـ الإضلال الإلهي.
68ـ الأمر الإلهي.
69ـ الجبارية الإلهية.
70ـ النظم الإلهي.
71ـ سريع الحساب.
72ـ الذاكر.
73ـ بدع خلق الله.
74ـ القرب الإلهي.
75ـ شديد العقاب.
76ـ صادق الوعد.
77ـ صاحب العظمة والإكرام.
78ـ الإحاطة الإلهية.
79ـ الغفّار.
80ـ الإنشاء الإلهي.
81ـ التوّاب.
82ـ الإعادة الإلهية.
83ـ المُبدِئ.
84ـ الإنشاء الإلهي.
85ـ المحافظة الإلهية.
86ـ الستر الإلهي.
87ـ الحفظ الإلهي.
88ـ الوقاية الإلهية.
89ـ قاضي الحاجات.
90ـ العون الإلهي.
91ـ النجاة الإلهية.
92ـ الأنس الإلهي.
93ـ الظلّ الإلهي.
94ـ الانتقام الإلهي.
95ـ الستر الإلهي.
96ـ الشفاء الإلهي.
97ـ الإعزاز الإلهي.
98ـ النصرة الإلهية.
99ـ الزينة الإلهية.
100ـ الفضل الإلهي.
101ـ الإكمال الإلهي.
102ـ الحصانة الإلهية.
103ـ الإكرام الإلهي.
104ـ الرفعة الإلهية.
105ـ الإجابة الإلهية.
106ـ النجاة الإلهية.
107ـ العفو الإلهي.
108ـ الجزاء الإلهي.
109ـ مطلق الأسارى.
110ـ الدفع الإلهي للبلاء.
111ـ الخيرات الإلهية.
112ـ مقلّب القلوب.
113ـ الإحسان الإلهي.
114ـ الاستعراض الإلهي.
115ـ آمرية الله.
116ـ الاستيلاء الإلهي.
117ـ الإحياء الإلهي.
118ـ الإماتة الإلهية.
119ـ رفيع الدرجات.
120ـ الغلبة الإلهية.
121ـ البطش الإلهي.
122ـ النفع الإلهي.
123ـ التزكية الإلهية.
124ـ الرعاية الإلهية.
125ـ الكنف الالهي.
126ـ الإرادة الإلهية.
127ـ الامتحان الإلهي.
128ـ التسهيل الإلهي.
129ـ الإبداع الإلهي.
130ـ الإنشاء الإلهي.
131ـ القضاء الإلهي.
132ـ السلطة الإلهية.
133ـ الحكم الإلهي.
134ـ الإمساك الإلهي.
135ـ القبول الإلهي للتوبة.
136ـ محوّل الحول.
137ـ الاستقراض الإلهي.
138ـ الإمحاء الإلهي.
139ـ الإبقاء الإلهي.
140ـ مسبّب الأسباب.
141ـ كاشف الضرّ.
142ـ القدرة الإلهيّة على الإيجاد والإعدام.
143ـ التكريم الإلهي.
144ـ السنن الإلهية.
145ـ معيّة الله.
146ـ الإذن الإلهي.
147ـ البعث الإلهي.
148ـ التمكين الإلهي.
يتمّ التطرّق في هذا الفصل إلى الموضوعات التي ترتبط بعمل الإنسان؛ من حيث كونه مخيّراً فيه أو مجبراً عليه مستندين في إثبات ذلك إلى أحاديث سيّد الشهداء× وخطاباته وأدعيته؛ مؤيّدة بالآيات والروايات الواردة عن أهل البيت^. وتتمثل هذه الموضوعات بما يلي:
1ـ تأثير المدد الإلهي في أفعال الإنسان.
2ـ نحو خلق الإنسان.
3ـ كيفية تدخّل الله في شقاء الإنسان.
4ـ الإجراءات الإلهية لكمال الإنسان.
5ـ مضار القول بالجبر.
6ـ أنواع الجبر.
7ـ الجبر الحسن.
8ـ بطلان الجبر.
9ـ نسبة الفعل للإنسان.
10ـ الأمور الخارجة عن اختيار الإنسان.
11ـ علاقة إرادة الإنسان بإرادة الله.
12ـ أسباب نسبة فعل الإنسان لله سبحانه.
13ـ ما لا يتدخّل الله في ارتكابه.
14ـ اضطرار الإنسان.
15ـ الأمور المؤثرة في قدرة الإنسان.
16ـ الأمور التي لا تتنافى مع اختيار الإنسان.
17ـ الإنسان مختار عند ارتكاب الذنب.
18ـ الإنسان مختار عند قيامه بالطاعة.
19ـ الفرق بين الغلبة والإكراه.
20ـ حقيقة الأمر بين الأمرين.
21ـ كيفية قدرة الإنسان بالنسبة إلى ما قدّر له.
22ـ علاقة استطاعة الإنسان بإطاعة أوامر الله.
23ـ قدرة الإنسان على امتثال الأوامر الإلهية.
24ـ صلة العمل بالنيّة.
25ـ جواز نسبة الفعل للسبب والمباشر في نفس الوقت.
26ـ الأمور المقدورة للإنسان.
27ـ شواهد على نفي الجبر.
28ـ دوافع القول بالجبر.
من جملة أدلّة علم الإمام الحسين× باستشهاده، تأكيده على مسألة القضاء والقدر، لا سيما في أواخر عمره الشريف، وكأنّه يعدّ نهضته وشهادته مصداقاً بارزاً لهما، لذا سوف نبحث في هذه الموسوعة موضوعي القضاء والقدر ونتناول تفاصيل كل منهما على حدة.
أ) القضاء الإلهي:
1ـ القضاء الإلهي.
2ـ حكم القضاء الإلهي.
3ـ ما يتعلّق به القضاء الإلهي.
4ـ وظائفنا تجاه القضاء الإلهي.
5ـ علاقة القضاء الإلهي بصفات الذات.
6ـ اختيار الله في قضائه.
7ـ أنواع القضاء الإلهي.
8ـ آثار التسليم لقضاء الله وقدره.
9ـ آفات القضاء والقدر.
10ـ المدد الإلهي في القضاء والقدر.
11ـ تأثير القضاء الإلهي في اختيار الإنسان.
12ـ القضاء العمومي الإلهي.
13ـ مقدّمات القضاء الإلهي.
ب) القدر الإلهي:
1ـ حقيقة القدر.
2ـ خصائص القدر الإلهي.
3ـ أنواع القدر الإلهي.
4ـ وظائفنا تجاه القدر الإلهي.
5ـ التقدير الإلهي للأسباب.
6ـ الاختلاف في التقدير الإلهي.
7ـ ما يتعلّق به القدر الإلهي.
8ـ تأثير القدر الإلهي في اختيار الإنسان.
9ـ تحقق المقدّر.
10ـ آثار الاعتقاد بالقدر.
إنّ لله تعالى حقوقاً على الخلق أشير إليها في الآيات والروايات، وعندما نرجع إلى كلمات الإمام الحسين× نجد أنّها أشارت أيضاً إلى جملةٍ من تلك الحقوق من قبيل:
أ) الحقوق الإلهية.
ب) الحقوق الإلهية الخاصّة.
ج) خصائص الحقوق الإلهية.
د) آثار أداء الحقوق الإلهية.
ﻫ) تقصير الإنسان في أداء الحقوق الإلهية.
و) عوامل ترك الحقوق الإلهية.
ز) نماذج من الحقوق الإلهية:
1ـ الحمد.
2ـ الخشية.
3ـ ترك الحدّة مع الله تعالى.
4ـ الثّناء.
5ـ التّواضع لجلال الله تعالى.
6ـ ترك المعصية.
7ـ الشكر.
8 ـ الطّاعة.
9ـ عدّ نعم الله تعالى.
10ـ الإخلاص في العمل.
11ـ ترك الذّنوب.
12ـ إظهار النّدامة من الذّنب.
13ـ تمجيد الله تعالى.
14ـ تذكّر نعم الله تعالى.
15ـ المحبّة.
16ـ الرّجاء بالله تعالى.
17ـ الخوف من الله تعالى.
18ـ التّوكل على الله تعالى.
19ـ إظهار العبوديّة.
20ـ عدم المنّة.
21ـ الثّقة بالله تعالى.
22ـ رعاية حرمة نعم الله تعالى.
23ـ العبوديّة.
24ـ التّسبيح.
25ـ الاستغفار من الذّنوب.
26ـ قضاء حوائج النّاس.
27ـ رعاية التّقوى.
28ـ العُتبى.
29ـ الاعتراف بالذّنوب.
30ـ الاعتراف بحقارة النّفس.
31ـ تقديس الله تعالى.
32ـ الإخلاص في العبوديّة.
33ـ مؤاخذة المذنبين.
34ـ التّضرع.
35ـ التّسليم للقدر الإلهي.
36ـ توصيف الله بما جاء في القرآن والسنّة.
37ـ رعاية الأمور الإلهية.
38ـ ذكر الله تعالى.
39ـ حسن الظن بالله تعالى.
40ـ الإقرار بالنّعمة.
41ـ التنزيه المطلق.
42ـ التوسّل بالفضل الإلهي.
43ـ طلب مرضات الله تعالى.
44ـ رعاية العدل والإنصاف.
تعدّ النبوّة أصلاً من أصول الدين عند المسلمين، ولذا يتمّ البحث عنها في الكتب العقائدية على ثلاثة محاور أشارت إليها كلمات الإمام الحسين× أيضاً، مثل:
أ) مباحث النبوّة العامّة:
1ـ ضرورة البعثة.
2ـ النبي والرسول.
3ـ الوحي.
4ـ نقد نظرية التجربة النبوية.
5ـ العصمة.
6ـ المعجزة.
7ـ علم الغيب.
ب) مباحث النبوّة الخاصة
1ـ نبوّة نبي الإسلام’.
2ـ عصمة النبي|.
3ـ علم غيب النبي|.
4ـ مرجعية رسول الله| الدينية.
5ـ خصائص نبي الإسلام|.
6ـ عظمة نبي الإسلام|.
7ـ وصيّة النبي|.
8ـ علاقة النبي| بأهل بيته.
9ـ مكانة النبي| ومقامه.
10ـ السنّة النبوية.
11ـ زوجات النبي|.
12ـ مسجد النبي|.
13ـ شفاعة النبي|.
14ـ حرمة النبي|.
15ـ وظائفنا تجاه نبي الإسلام|.
16ـ حقوق رسول الله|.
17ـ نور النبي|.
18ـ نزول الوحي على رسول الله|.
19ـ أعداء النبي|.
20ـ بركات النبي|.
21ـ معجزات النبي|.
ج) الأنبياء:
1ـ وظائف الأنبياء.
2ـ خصائص الأنبياء.
3ـ تعاليم الأنبياء.
4ـ المدد الإلهي للأنبياء.
5ـ أحوال الأنبياء.
6ـ ما قام به الأنبياء من أجل هداية البشر.
7ـ ردود فعل الناس إزاء هداية البشر.
8ـ وظيفة الناس تجاه دعوة الأنبياء.
9ـ كفاح الأنبياء.
10ـ بركات الأنبياء.
11ـ درجات الأنبياء.
12ـ حقوق الأنبياء.
13ـ ابتلاءات الأنبياء.
14ـ العقائد المنحرفة حول الأنبياء.
استعرضت كلمات الإمام الحسين× الكثير من الأبحاث القرآنية، ولذا أفردنا لها باباً منفصلاً عن بحث النبوّة ومباحثها تحت العناوين التالية:
1ـ الكتب السماوية.
2ـ القرآن والوحي الإلهي.
3ـ نزول القرآن.
4ـ نورانية القرآن.
5ـ خصائص القرآن.
6ـ تلاوة القرآن.
7ـ استماع القرآن.
8ـ حفظ القرآن.
9ـ التوجيهات القرآنية.
10ـ الأخبار القرآنية.
11ـ الصلة بين القرآن الناطق والقرآن الصامت.
12ـ وظائف الإنسان تجاه القرآن.
13ـ الحروف المقطّعة.
14ـ صفات القرآن.
15ـ تحريف القرآن.
16ـ مهجوريّة القرآن.
17ـ شموليّة القرآن.
18ـ الأمور المرتبطة بالقرآن.
19ـ فهم القرآن.
20ـ تفسير آيات القرآن.
21ـ تطبيق آيات القرآن.
22ـ تأويل آيات القرآن.
23ـ حقائق آيات القرآن.
24ـ شأن نزول الآيات القرآنية.
25ـ أسماء السور.
26ـ ظاهر القرآن.
27ـ باطن القرآن.
28ـ إعجاز القرآن.
29ـ حفظ القرآن.
تعدّ الإمامة أصلاً من أصول الدين الخمسة عند الشيعة، وتضمّ الكثير من المباحث الكلية التي ترتبط بإمامة الأئمّة الاثني عشر^ والتي يعبّر عنها بالإمامة العامّة. في هذا الفصل سنتناول بالبحث مسائل الإمامة العامّة التي وردت في كلمات سيّد الشهداء×:
أ) مباحث الإمامة:
1ـ حقيقة الإمامة.
2ـ منصب الإمامة.
3ـ شروط الإمامة.
4ـ خصائص الإمامة.
5ـ علامات الإمامة.
ب) مباحث الإمام:
1ـ مقام الإمام.
2ـ ضرورة الإمام.
3ـ صفات الإمام.
4ـ عصمة الإمام.
5ـ وظائف الإمام.
6ـ إتمام الحجّة بالإمام.
7ـ كلام الإمام.
8ـ وظائف الناس تجاه الإمام.
9ـ آثار الإمام.
10ـ علم غيب الإمام.
11ـ ولاية الإمام.
12ـ علم الإمام.
13ـ ارتباط الإمام بالقرآن.
14ـ حاكمية الإمام.
15ـ خصائص الإمام.
16ـ حقوق الإمام.
17ـ مضارّ الابتعاد عن الإمام.
18ـ درجات الأئمّة.
19ـ آثار طاعة الإمام.
20ـ رؤيا الإمام.
21ـ معجزة الإمام.
22ـ إثبات إمامة الإمام.
23ـ علم الإمام اللدنّي.
24ـ الوصيّة على الإمام.
تختص مباحث هذا الموضوع بالأئمّة بعد رسول الله|، وإثبات إمامتهم والصفات المتعلّقة بها. نتناول في هذا الفصل الموضوعات المرتبطة بالأئمّة الاثني عشر المعصومين^ وخاصّة الإمام علي×، ونقوم بشرح كل موضوع على حدة، كما يلي:
أ) إمامة أهل البيت^.
1ـ إثبات إمامة أهل البيت^.
2ـ خصائص أئمة أهل البيت^.
3ـ صفات أئمة أهل البيت^.
4ـ أهل البيت^ بعد الرسول|.
5ـ الأئمّة من ذرية الإمام الحسين×.
6ـ مرجعيّة أهل البيت^ العلمية.
7ـ عدد أئمة أهل البيت^.
8ـ وظائفنا تجاه أئمة أهل البيت^.
ب) إمامة أمير المؤمنين علي×:
1ـ إثبات إمامة أمير المؤمنين علي×.
2ـ فضائل أمير المؤمنين علي×.
3ـ أهمية ولاية أمير المؤمنين علي×.
4ـ خصائص أمير المؤمنين علي×.
5ـ المؤامرات ضدّ أمير المؤمنين علي×.
تتطرّق أحاديث الإمام الحسين× إلى فضائل أهل بيت العصمة والطهارة^ وخصائصهم وسيرتهم، لذا أفردنا فصلاً لبيانها ضمن العناوين التالية:
1ـ مفهوم أهل البيت^.
2ـ خلق أهل البيت^.
3ـ جسم أهل البيت^.
4ـ أهل البيت^ العلّة الغائية للعالم.
5ـ العناية الإلهية بأهل البيت^.
6ـ هداية أهل البيت^.
7ـ أحوال أهل البيت^.
8ـ ارتباط أهل البيت^ بالله.
9ـ أهل البيت^ والقرآن.
10ـ خصائص أهل البيت^.
11ـ ما يريده أهل البيت^.
12ـ معارضي أهل البيت^.
13ـ ما يحتاجه أهل البيت^.
14ـ ارتباط أهل البيت^ بالنبي|.
15ـ أهل البيت^ والدنيا.
16ـ وظائفنا تجاه أهل البيت^.
17ـ أهل البيت^ وأداؤهم للوظائف.
18ـ ارتباط أهل البيت^ بالناس.
19ـ مقام أهل البيت^.
20ـ صلة أهل البيت^ مع بعضهم.
21ـ مُدرَكات أهل البيت^.
22ـ المتوقّع من أهل البيت^.
23ـ وظائف أهل البيت^.
24ـ سياسة أهل البيت^.
25ـ علوم أهل البيت^.
26ـ بركات أهل البيت^.
27ـ أهل البيت^ والملائكة.
28ـ محبّو أهل البيت^.
29ـ محبّة أهل البيت^.
30ـ شيعة أهل البيت^.
31ـ أحقيّة أهل البيت^.
32ـ الأعمال المحبوبة لدى أهل البيت^.
33ـ أفضلية أهل البيت^.
34ـ ابتلاءات أهل البيت^.
35ـ أعداء أهل البيت^.
36ـ رجعة أهل البيت^.
إنّ لأهل البيت^ على الناس حقوقاً خاصة لا سيما لدى أتباعهم، وقد أشارت الآيات والروايات إلى تلك الحقوق كما نجد في الروايات المنسوبة للإمام الحسين× إشارات إليها، من قبيل:
1ـ حقوق رسول الله| على الناس.
2ـ حقوق أهل البيت^ على الناس.
3ـ حقوق أمير المؤمنين× على الناس.
4ـ حقوق فاطمة الزهراء‘ على الناس.
5ـ حقوق الإمام الحسين× على الناس.
6ـ حقوق أقرباء رسول الله| على الناس.
7ـ حقوق أهل البيت^ على الله.
8ـ الدعاء بحق الأولياء.
9ـ وظائف أصحاب أهل البيت^.
10ـ منكرو حقوق أهل البيت^.
11ـ حقّ الإنسان على الإمام.
12ـ آثار رعاية حقوق أهل البيت^.
13ـ جزاء مضيعي حقوق أهل البيت^.
14ـ آثار حقوق أهل البيت^.
ذكر الإمام الحسين× في أحاديثه وكلماته مطالب كثيرة تتعلّق بنفسه، بحيث يمكن أن تُطرح وتُشرح في كتابٍ مستقل، من ضمنها:
1ـ نسب الإمام الحسين×.
2ـ خصائص الإمام الحسين×.
3ـ مظلوميّة الإمام الحسين×.
4ـ ارتباط الإمام الحسين× بالله تعالى.
5ـ ارتباط الإمام الحسين× بأهل البيت^.
6ـ إمامة الإمام الحسين×.
7ـ العناية الإلهية بالإمام الحسين×.
8ـ الإمام الحسين× في القرآن.
9ـ العزّة الحسينية.
10ـ علم الإمام الحسين× بشهادته.
11ـ علم الإمام الحسين×.
12ـ بركات الإمام الحسين×.
13ـ وظائفنا تجاه الإمام الحسين×.
14ـ أعداء الإمام الحسين×.
15ـ وصايا الإمام الحسين×.
16ـ مُراد الإمام الحسين×.
17ـ نهضة الإمام الحسين×.
18ـ رجعة الإمام الحسين×.
19ـ أصحاب الإمام الحسين×.
20ـ الإمام الحسين× والصحابة.
21ـ علم غيب الإمام الحسين×.
22ـ العلم اللدني للإمام الحسين×.
23ـ أسباب وعوامل نهضة الإمام الحسين×.
24ـ النظرة السياسية للإمام الحسين×.
من الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير لدى الأمة الإسلامية بل وفي جميع الأديان الإلهية وأشارت إليها الروايات بصورة كبيرة مسألة المهدوية وظهور الإمام المهدي# في آخر الزمان وكيفية حكومته، وقد أشارت الروايات الواردة عن سيّد الشهداء× إلى هذه المسألة بصورة واسعة، بما في ذلك الموضوعات التالية:
1ـ المهدوية.
2ـ ولادة المهدي#.
3ـ ألقاب المهدي#.
4ـ وجود المهدي#.
5ـ خصائص المهدي#.
6ـ القرآن والمهدوية.
7ـ الغيبة الكبرى.
8ـ وظائفنا في عصر الغيبة الكبرى.
9ـ عدم خلوّ الأرض من الحجّة.
10ـ انتظار الفرج.
11ـ ظهور المهدي#.
12ـ علامات الظهور.
13ـ العوامل الاجتماعية لظهور الإمام المهدي#.
14ـ عصر الظهور.
15ـ إجراءات المهدي# في عصر الظهور.
16ـ الوضع الاقتصادي في عصر الظهور.
17ـ السنّة المهدوية.
18ـ الرجعة.
المعاد من أصول الدين الإسلامي بل من أصول الأديان السماوية كافة، وقد أشار الإمام الحسين× إلى هذا الأصل في أحاديثه كثيراً، كما تطرّقت له الآيات الشريفة وسنّة المعصومين^ بصورة مفصّلة. من المباحث الكلية المتعلّقة بالمعاد والتي وردت الإشارة إليها في كلام الإمام الحسين× ما يلي:
أ) الموت:
1ـ وظائف الإنسان قبل الموت.
2ـ حقيقة الموت.
3ـ حقوق الأموات.
4ـ حقوق ورثة الأموات.
5ـ تجهيز الميت.
ب) البرزخ:
1ـ عالم البرزخ.
2ـ الحياة البرزخيّة.
3ـ بقاء الإنسان.
4ـ ما يحتاجه الإنسان في القبر.
5ـ أحوال الإنسان في القبر.
6ـ العلاقة بين الدنيا والبرزخ.
7ـ زيارة القبور.
8ـ علم الغيب البرزخي.
9ـ حقوق الأولياء في البرزخ.
10ـ أحوال الأولياء في البرزخ.
ج) المعاد:
1ـ أشراط الساعة.
2ـ حقيقة المعاد.
3ـ عالم الآخرة.
4ـ الدرجات الأخروية.
5ـ الآثار التربوية للاعتقاد بالمعاد.
6ـ رجوع الإنسان إلى الله.
7ـ تجسّد الأعمال.
8ـ الشفاعة.
9ـ حوض الكوثر.
10ـ لواء الحمد في القيامة.
11ـ أحوال الناس في القيامة.
12ـ صحيفة الأعمال.
13ـ أجر العمل.
14ـ الودائع عند الله.
15ـ حساب الأعمال.
16ـ المشهود يوم القيامة.
17ـ ثواب الأعمال.
18ـ اللطف الإلهي بالمذنبين يوم القيامة.
19ـ المساءلة يوم القيامة.
20ـ الشهادات الضرورية.
21ـ حاجات الإنسان في القيامة.
22ـ النفخ في الصور.
23ـ الإحباط والتكفير.
24ـ وظائف الإنسان في القيامة.
25ـ أحوال الإنسان في القيامة.
26ـ العدالة في الجزاء.
27ـ المنادون في القيامة.
د) الجنة:
1ـ مكانة أهل الجنة.
2ـ عوامل صيرورة الإنسان من أهل الجنة.
3ـ نِعَم الجنة.
4ـ كون الجنة مخلوقة.
5ـ أنواع الجنان.
6ـ مراتب أهل الجنة.
7ـ درجات الجنة.
ﻫ) جهنم:
1ـ عذاب جهنم.
2ـ أسباب صيرورة الإنسان من أهل جهنم.
3ـ عوامل النجاة من النار.
4ـ خصائص أهل النار.
5ـ أنواع العذاب.
6ـ خازن النار.
احتلّ الدعاء وخصوصياته وإبداء السخط على الأعداء مجالاً واسعاً في كلام سيّد الشهداء×، ولسعة مباحث هذين الأمرين أفردنا لهما باباً خاصاً تحت العناوين التالية:
1ـ مفهوم الدعاء.
2ـ مترادفات الدعاء.
3ـ دوافع الدعاء.
4ـ فطريّة الدعاء.
5ـ آثار الدعاء.
6ـ حسن الدعاء.
7ـ أدب الدعاء.
8ـ شروط الدعاء.
9ـ أنواع الدعاء.
10ـ رغبات الإنسان في الدعاء.
11ـ ترك الإنسان الدعاء.
12ـ مواضع حُسن الدعاء والمناجاة.
13ـ رعاية نظام الأسباب والمسبّبات في الدعاء.
14ـ الأوقات المناسبة للدعاء.
15ـ الأماكن المناسبة للدعاء.
16ـ وظائف الداعي حين الشروع بالدعاء.
17ـ وظائف الداعي حين الانتهاء من الدعاء.
18ـ عوامل التقرّب إلى الله في الدعاء.
19ـ الله تعالى سامع الدعاء.
20ـ تنوّع أدعية الإنسان.
21ـ حاجة الإنسان إلى الدعاء.
22ـ حقوق الداعي.
23ـ الأفراد المستحقّون للدعاء لهم.
24ـ الأفراد المستحقّون للدعاء عليهم.
25ـ العوامل المؤثرة في استجابة الدعاء.
26ـ عوامل تأخير استجابة الدعاء.
27ـ حتميّة استجابة الدعاء.
28ـ مجيب الدعاء.
29ـ آثار استجابة الدعاء.
30ـ خصوصيات استجابة الدعاء من الله تعالى.
31ـ درجات الأفراد في استجابة أدعيتهم.
32ـ المحرومون من إجابة الدعاء.
33ـ مجابو الدعاء.
34ـ حقوق مجيب الدعاء.
35ـ الأدعية المضمونة الاستجابة.
36ـ مربّو الإنسان على كيفية الدعاء.
37ـ العارفون بالدعاء.
38ـ الأدعية الموصّى بها.
أخذت الأخلاق مكانة هامةً في أحاديث سيّد الشهداء× بحيث تستحق أن نفرد لها باباً ونشرحها تحت العناوين التالية:
أ) الأخلاق الحسنة:
1ـ القناعة.
2ـ الشكر.
3ـ الرضا.
4ـ الذكر.
5ـ سعة الصدر.
6ـ القرب الإلهي.
7ـ التقوى.
8ـ الإخلاص.
9ـ النور المعنوي.
10ـ البصيرة.
11ـ تهذيب النفس.
12ـ صلة الرحم.
13ـ العزّة.
14ـ حسن العاقبة.
15ـ الجود والكرم.
16ـ الحلم والتحمّل.
17ـ الابتلاء.
18ـ الخوف من الله.
19ـ التوكّل.
20ـ الإتقان في العمل.
21ـ الإحسان إلى الخلق.
22ـ المحبّة الإلهية.
23ـ السلوك الحسن.
24ـ الصدق.
25ـ الصبر.
26ـ المراقبة.
27ـ الخشية من الله.
28ـ الورع.
29ـ حسن الظن.
30ـ الصداقة.
31ـ الزهد.
32ـ الرفق والمداراة.
33ـ الأمانة.
34ـ حُسن الخلق.
35ـ الصمت والسكوت.
36ـ الشجاعة.
37ـ العفو والمغفرة.
38ـ العفّة.
39ـ الإيثار.
40ـ الألفة.
41ـ العبوديّة.
42ـ الشرف.
43ـ تكفّل الأيتام.
44ـ مجالسة الصالحين.
45ـ الوفاء بالعهد.
46ـ المروءة.
47ـ السلام.
48ـ النصيحة وحبّ الخير.
49ـ الحياء.
50ـ الاعتبار.
51ـ الخضوع.
52ـ اللجوء إلى الله.
53ـ قضاء حوائج الناس.
54ـ إصلاح ذات البين.
55ـ الفضيلة.
56ـ الإنابة.
57ـ المواساة.
58ـ العمل بالعلم.
59ـ الفتوّة والرجولة.
60ـ السبق إلى فعل الخير.
61ـ قبول العذر.
62ـ حفظ ماء الوجه.
63ـ حفظ حرمة المؤمن.
64ـ غنى النفس.
65ـ صون النفس والدين.
66ـ الأمور التي يجب الهروب منها إلى الله.
67ـ مداراة الناس.
68ـ الخلاص من قيود الشهوات.
69ـ التسليم لله.
70ـ إصلاح الأمور.
71ـ الرغبة في الآخرة.
ب) الأخلاق السيئة:
1ـ التكبّر.
2ـ الوقاحة والجرأة على الله.
3ـ الابتعاد عن الله.
4ـ الحرص.
5ـ اليأس من رحمة الله.
6ـ كفران النعمة.
7ـ خلف الوعد.
8ـ اتّباع الشهوات.
9ـ الظلم.
10ـ الغضب.
11ـ الطغيان.
12ـ الكذب.
13ـ البخل.
14ـ الغيبة.
15ـ الحقد.
16ـ قطيعة الرحم.
17ـ الجسارة.
18ـ الخيانة.
19ـ العداوة.
20ـ الأمن من العذاب الإلهي.
21ـ التهمة.
22ـ الغرور.
23ـ العُجب.
24ـ الغفلة.
25ـ التملّق.
26ـ الكلام في غير محلّه.
27ـ الصراع.
28ـ الحسد.
29ـ الذلّة والضعة.
30ـ الطمع بما عند الناس.
31ـ إثارة العداوة.
32ـ الأماني الطويلة والبعيدة.
33ـ طلب الدنيا.
34ـ الصيرورة من أهل الباطل.
35ـ سلاطة اللسان.
36ـ أكل الحرام.
37ـ عبادة الشيطان.
38ـ الجزع.
39ـ اتّباع الهوى.
40ـ الخسة والحقارة.
41ـالتكلّف العبثي.
42ـ المنّة.
43ـ الوشاية.
44ـ اللهو واللعب.
45ـ التشاؤم.
نشير في هذا الباب إلى المباحث العرفانية التي تناولتها أحاديث سيّد الشهداء× وخاصة أدعيته الشريفة لا سيما دعاء عرفه وتتمته، وسيكون البحث في العناوين التالية:
1ـ إمكان السلوك.
2ـ ضرورة السلوك.
3ـ عوامل السلوك.
4ـ مرشد السلوك.
5ـ زاد السلوك.
6ـ مقصد السلوك.
7ـ موانع السلوك.
8ـ مطية السلوك.
9ـ ثمرات السلوك.
10ـ مدّة السلوك.
11ـ سبل السلوك.
12ـ ظروف السلوك.
13ـ مراحل السلوك.
14ـ منعطفات السلوك.
15ـ متطلبات السلوك.
16ـ المخالفون للسلوك.
17ـ الدعوة إلى السلوك.
18ـ وظائف السالكين.
19ـ مقامات السالكين.
20ـ السالكون إلى الله.
تطرّقنا في هذا الباب إلى أحاديث سيّد الشهداء× التي يذكر فيها أصحابه وصفاتهم وخصائصهم والأمور التي يتصّف بها شيعة أهل البيت^ ضمن العناوين التالية:
1ـ شيعة أهل البيت^.
2ـ أنواع الشيعة.
3ـ درجات الشيعة.
4ـ شيعة الإمام الحسين×.
5ـ وظائف الشيعة.
6ـ خصائص الشيعة.
7ـ وضعيّة الشيعة في عصر الغيبة.
8ـ مشكلات الشيعة في عصر الغيبة.
9ـ وظائف العلماء تجاه الشيعة.
10ـ مكانة علماء الشيعة.
11ـ خصائص متكفّلي الشيعة.
12ـ فضائل الشيعة.
13ـ شيعة الكوفة.
14ـ أحقية الشيعة ونفي التعدديّة المذهبية.
15ـ من هم أعداء الشيعة؟
16ـ شهداء الدفاع عن حريم أهل البيت^.
17ـ الشيعة في عصر الظهور.
نتطرّق في هذا الفصل إلى المطالب المرتبطة بعلم الحديث من قبيل:
1ـ وظائفنا تجاه روايات المعصومين^.
2ـ أنواع الخبر.
3ـ الصحابة ونقل الحديث من النبي|.
4ـ سماع الحديث.
5ـ بطلان نظريّة عدالة كلّ الصحابة.
6ـ كتابة الحديث.
7ـ تحمّل الحديث.
8ـ صدق وكذب الحديث.
9ـ درجات اعتبار الحديث.
10ـ رأي الإمام الحسين× في بعض الأحاديث.
11ـ حجيّة خبر الثقة.
12ـ حجيّة الخبر المستفيض.
13ـ مسانيد الإمام الحسين×:
أ) أحاديث الإمام الحسين× عن رسول الله|.
ب) أحاديث الإمام الحسين× عن الإمام علي×.
ج) أحاديث الإمام الحسين× عن فاطمة الزهراء‘.
د) أحاديث الإمام الحسين× عن الإمام الحسن×.
ﻫ) أحاديث الإمام الحسين× عن بعض الصحابة.
أخذت بعض الأحاديث المنسوبة لسيّد الشهداء× منحىً تاريخياً، ولذا تطرّقنا للبحث فيها بنحو مستقل من قبيل العناوين التالية:
أ) تاريخ الأنبياء^:
1ـ آدم×.
2ـ نوح×.
3ـ أيّوب×.
4ـ يونس×.
5ـ موسى×.
6ـ هارون×.
7ـ زكريّا×.
8ـ يحيى×.
9ـ داوود×.
10ـ سليمان×.
11ـ يعقوب×.
12ـ يوسف×.
13ـ إبراهيم×.
14ـ إسماعيل×.
15ـ عامّة الأنبياء^.
16ـ أمم الأنبياء^.
ب) تاريخ أهل البيت^:
1ـ عامّة أهل البيت^.
2ـ السيّدة الزهراء‘.
3ـ الإمام الحسن×.
4ـ الإمام الحسين×.
ج) تاريخ كربلاء:
1ـ أصحاب الإمام الحسين×.
2ـ عبيد الله بن زياد.
3ـ عمر بن سعد.
4ـ جيش عمر بن سعد.
د) تاريخ الصحابة:
1ـ الخلفاء.
2ـ عامّة الصحابة.
ﻫ) تاريخ بني أميّة:
1ـ أبو سفيان.
2ـ معاوية.
3ـ يزيد.
4ـ مروان.
5ـ بنو أميّةعامّة.
و) تاريخ الكوفة.
يمكننا استخراج مجموعة أبحاثٍ ترتبط بعلم الأصول من كلام الإمام الحسين× وجمعها في بابٍ مستقل أو جعلها مقدّمةً لمباحث الفقه من قبيل:
1ـ وجوب العمل بالتكليف.
2ـ كون الإنسان مكلّفاً.
3ـ شروط التكليف.
4ـ مراتب التكليف.
5ـ أنواع التكليف.
6ـ الأوامر.
7ـ أنواع الوجوب.
8ـ النواهي.
9ـ الرخص الإلهية.
10ـ الفرائض الإلهية.
11ـ الحكم.
12ـ من مقدّمات الحكم.
13ـ جعل الحكم.
14ـ أنواع الحكم.
15ـ الأحكام الإلهية.
16ـ مجاري الأحكام.
17ـ تزاحم الملاكات.
18ـ السنن الإلهية.
19ـ البدعة والسنّة.
20ـ حجيّة السنّة النبوية.
21ـ ضرورة المرجعية الدينية لأهل البيت^.
22ـ حجيّة سنّة أهل البيت^.
23ـ حجيّة الظواهر.
24ـ الاحتياط ونظريّة حقّ الطاعة.
25ـ القياس.
26ـ العام والخاص.
27ـ الإجماع.
28ـ العقل.
29ـ باب التعارض.
30ـ التقيّة.
31ـ قاعدة الإلزام.
32ـ الشرط.
33ـ الظنّ.
أشارت أحاديث سيّد الشهداء× إلى بعض المباحث الفقهية التي تُطرح وتدرس في كتب الفقه من قبيل الأمور التالية:
1ـ الطهارة.
2ـ الصلاة.
3ـ المساجد.
4ـ الزكاة.
5ـ الحجّ.
6ـ الجهاد.
7ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8ـ المكاسب.
9ـ البيع.
10ـ الصّلح.
11ـ الوديعة.
12ـ الأمانة.
13ـ الدَّين.
14ـ الرّهن.
15ـ الضمان.
16ـ الكفالة.
17ـ الوكالة.
18ـ الإقرار.
19ـ الهبة.
20ـ الوقف.
21ـ الصدقة.
22ـ الوصيّة.
23ـ القَسم.
24ـ العهد.
25ـ الصيد والذباحة.
26ـ الأطعمة والأشربة.
27ـ الغصب.
28ـ إحياء الموات.
29ـ السبق والرماية.
30ـ النكاح.
31ـ الطلاق.
32ـ العتق.
33ـ الإرث.
34ـ القضاء.
35ـ الشهادات.
36ـ الحدود.
37ـ القصاص.
38ـ الديّات.
39ـ ولاية الفقيه.
31 ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
يُعدّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلّة الأساس لقيام سيّد الشهداء× وخروجه، وقد أشار× إلى هذين الأمرين في كلامه كثيراً لا سيما في أواخر عمره الشريف، لذا سنبحث فيهما تحت العناوين التالية:
1ـ مفهوم المعروف.
2ـ مفهوم المنكر.
3ـ وظائفنا تجاه المعروف.
4ـ وظائفنا تجاه المنكر.
5ـ خصائص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
6ـ الأمور التي يجب الأمر بها.
7ـ الأمور التي يجب النهي عنها.
8ـ المنكرات التي يجب القضاء عليها.
9ـ شروط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
10ـ الأمور المؤثرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
11ـ درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
12ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملياً.
13ـ تبدّل المعروف والمنكر.
14ـ فوريّة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
15ـ جزاء التعرّض للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر.
16ـ عدم موافقة المعروف لميول الإنسان أحياناً.
17ـ الوظائف المشتركة حين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
18ـ آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
19ـ آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
20ـ التقيّة.
قام الإمام الحسين× للجهاد في سبيل الله ومقارعة الطاغية يزيد بن معاوية وهو على علمٍ باستشهاده وما سيحلّ به وأهل بيته في هذا الطريق، لذا أشارت كلماته الشريفة إلى هذين الأمرين بصورة واسعة مما دفعنا للبحث فيهما بنحوٍ مفصّل تحت العناوين الواردة في الروايات المنسوبة إليه× من قبيل:
أ) الجهاد:
1ـ حكم الجهاد.
2ـ أنواع الجهاد.
3ـ شروط الجهاد.
4ـ آفات ترك الجهاد.
5ـ درجات الجهاد.
6ـ آثار الجهاد.
7ـ آداب الجهاد.
8ـ الأعمال التي في حكم الجهاد.
9ـ الأمور التي ليست في حكم الجهاد.
10ـ الأمور التي يمكن تأخير الجهاد لأجلها.
11ـ من سقط عنه الجهاد.
12ـ الجهاد والنصر.
13ـ غنائم الحرب.
14ـ من يحرم جهادهم.
ب) المجاهدون:
1ـ أنواع المجاهدين.
2ـ وظائفنا تجاه المجاهدين.
3ـ صلاحيّات قائد المجاهدين.
4ـ معضلات المجاهدين.
5ـ العوامل المؤثرة في بث الاطمئنان بين المجاهدين.
6ـ حقوق المجاهدين.
7ـ وظائف المجاهدين في سبيل الله.
8ـ خصائص المجاهدين في سبيل الله.
9ـ من حقوق غير المقاتلين.
ج) من يجب جهادهم:
1ـ الخارجون على الإمام.
2ـ تبعات الخروج على الإمام.
3ـ وظائفنا تجاه الخارجين على الإمام.
4ـ حكم الخروج على الإمام.
5ـ حكم قتل الإمام.
6ـ تبعات قتل الإمام.
7ـ أسباب الخروج على الإمام.
8ـ أسباب قتل الإمام.
د) الشهادة:
1ـ آداب الشهادة.
2ـ حسن الشهادة.
3ـ آثار الشهادة في سبيل الله.
4ـ حُسن طلب الشهادة من الله.
5ـ خصائص الموت شهيداً.
6ـ وظائف طالبي الشهادة.
7ـ أفضل من الشهادة.
8ـ درجات الشهادة.
9ـ المنتظرون للشهادة.
10ـ دور الزمان والمكان في تأثير الشهادة.
11ـ الشهادة انتقاء.
ﻫ) الشهيد:
1ـ حكم الشهيد.
2ـ حرمة أسر الشهداء.
3ـ حرمة دم الشهداء.
5ـ وظائفنا تجاه الشهداء.
6ـ أنواع الشهداء.
نظراً لأهمية المباحث المرتبطة بالنظام الاقتصادي للمجتمع، واستقلال هذا العلم عن علم الفقه، أفردنا لها باباً في هذه الموسوعة للبحث فيها بشكلٍ خاص والمواضيع هي:
1ـ من عوامل الفساد الاجتماعي (الفقر).
2ـ من المصادر الاقتصادية (الزكاة).
3ـ المكاسب.
4ـ البيع.
5ـ الصلح.
6ـ الدَّين.
7ـ الملكية في الإسلام.
8ـ الملكية الخاصة في الإسلام.
9ـ آثار الملكية الخاصة.
10ـ الإسراف.
11ـ جواز قبول المعونة المالية من الناس أحياناً.
12ـ وظيفة الإنسان تجاه أمواله.
13ـ إحياء الموات.
14ـ من العوامل الاقتصادية في العمل.
15ـ الاقتصاد في طلب الرزق.
16ـ من أسباب البطالة.
17ـ حثّ الإسلام على العمل.
18ـ الصدمات الاقتصادية.
19ـ الملكية الاعتبارية.
20ـ كيفيّة ملكية الإنسان.
21ـ أسباب الجوع.
22ـ الوضعيّة الاقتصادية في عصر الظهور.
23ـ فرق المال والملك.
24ـ الاقتصاد المفيد.
25ـ الاقتصاد وسيلة.
26ـ من وظائف الأثرياء.
27ـ فشل بعض الدول اقتصادياً.
من المواضيع المطروحة للبحث والدراسة في هذا العصر موضوع النظام التربوي، حيث ينظر إليه في المجتمعات الحديثة كعلمٍ تخصصي مستقل، وقد أشار الإسلام إليه من خلال أحاديث الأئمّة المعصومين^ بما فيهم الإمام الحسين×، لذا سنبحثه في فصلٍ خاص تحت العناوين التالية:
1ـ التربية الدينية.
2ـ الهداية.
3ـ الأثر التربوي للعقيدة.
4ـ الأثر التربوي للكلام.
5ـ الأثر التربوي للعمل.
6ـ الطرق الإلهية لتربية الإنسان.
7ـ الطرق التربوية للدفاع عن النفس.
8ـ الطرق التربوية لتربية الأفراد.
9ـ سُبل تربية النفس.
10ـ طرق تربية الأفراد.
11ـ المحتاجون للتربية.
12ـ ولاية المتصدّي للتربية.
13ـ عوامل التربية.
14ـ موانع التربية.
15ـ الأمور التربوية.
16ـ مقام المعلّم التربوي.
17ـ وظائف المربّين التربويين.
18ـ وظائف الإنسان تجاه المربّي.
19ـ آثار التربية.
20ـ آفات التربية.
21ـ المربّي المنحرف.
22ـ الأفراد الذين تستحيل تربيتهم.
23ـ تربية الكبار.
نشير في هذا الفصل إلى سلسلة من المباحث المرتبطة بإدارة المجتمع والتي تمّت الإشارة إليها في كلمات سيّد الشهداء× من قبيل:
أ) الإدارة الثقافية:
1ـ وظائف المسؤولين الثقافيين.
2ـ أساليب مواجهة المنحرفين.
3ـ المتطلّبات الثقافية.
4ـ مواضع الصدام الثقافية.
5ـ الاستراتيجيات الثقافية الصحيحة.
6ـ المشاكل الثقافية.
7ـ وظائف المبلّغين الدينيين في الجيش.
8ـ آليات مواجهة المخالف.
ب) الإدارة التنفيذية:
1ـ المحاسبة.
2ـ وظائف المسؤولين تجاه الموظفين.
3ـ الحماية.
4ـ صلاحيات الموظفين.
5ـ حقوق العامل.
6ـ وظائف المسؤولين تجاه المفاسد الاجتماعية.
7ـ وظائف المسؤولين تجاه خيّري المجتمع.
8ـ وظائف المسؤولين تجاه الحكومة.
9ـ وظائف الموظفين تجاه القائد.
10ـ وظائف المسؤولين تجاه الناس.
11ـ وظائف الناس تجاه الموظفين.
12ـ آفات الموظفين.
13ـ علاقة القائد بالموظفين.
14ـ وصايا القائد للنوّاب.
15ـ صلاحيات النوّاب.
ج) الإدارة الأمنية:
1ـ ضرورة مواجهة المتآمرين.
2ـ التدابير الأمنية للحفاظ على القائد.
3ـ وظائف القوى الاستخباراتية تجاه العدو.
د) النظام الإداري:
1ـ دور الإدارة في المجتمع.
2ـ ضرورة القيام بالوظيفة من قبل المديرين.
3ـ النظام الإداري.
ﻫ) الإدارات الفاشلة
1ـ أسباب الفشل في الإدارة.
2ـ المدراء الفاشلون.
3ـ المشاكل الإدارية.
نتطرّق في هذا الفصل إلى روايات الإمام الحسين× التي تشير إلى علم الاجتماع والنظام الاجتماعي وبعض الأمور المرتبطة بنظم الأمور كالموضوعات التالية:
1ـ دور الفرد في المجتمع.
2ـ تأثير المجتمع في الحركات السياسية.
3ـ علم الاجتماع السياسي.
4ـ ضرورة تعزيز بعض الأمور في المجتمع.
5ـ علامات النفاق في المجتمع.
6ـ عوامل إنقاذ المجتمع من الجهل.
7ـ علل وأسباب الفساد الاجتماعي.
8ـ وظائف الأفراد تجاه المجتمع.
9ـ الطبقات الاجتماعية.
10ـ وظائفنا تجاه الأزمات الاجتماعية.
11ـ متطلّبات المجتمع.
12ـ أنواع المجتمعات.
13ـ مضارّ المجتمع الفاسد.
14ـ عوامل ظهور الهويّة الاجتماعية.
15ـ دور الأخلاق في المجتمع.
16ـ أضرار العلاقة الاجتماعية.
17ـ فوائد العلاقة الاجتماعية.
18ـ الطرق العملية المؤثرة في المجتمع.
19ـ الشخصيات الاجتماعية.
20ـ النكبات الاجتماعية.
21ـ المشاكل الاجتماعية.
22ـ وظائف قادة المجتمع.
23ـ ما يحتاجه قادة المجتمع.
24ـ العوامل المؤثرة في الحوادث الاجتماعية.
25ـ أنواع الدعوات الاجتماعية.
26ـ المصالح الاجتماعية.
27ـ القواعد الاجتماعية.
28ـ الحيثيات الاجتماعية.
29ـ الحقوق الاجتماعية.
30ـ عوامل الأفضلية الاجتماعية.
31ـ الحركة الاجتماعية.
32ـ تأثير الفرد في انحراف المجتمع.
33ـ الأحداث الاجتماعية.
34ـ السنن الاجتماعية.
35ـ البلايا الاجتماعية.
36ـ الحقائق الاجتماعية.
37ـ الإدارة الاجتماعية.
38ـ العلاقات الاجتماعية.
39ـ العوامل المخلّة بأمن المجتمع.
40ـ خصائص المجتمع الإسلامي.
41ـ سُبل نموّ المجتمع.
42ـ أسباب علنية الفساد في المجتمع.
43ـ التحوّل الاجتماعي.
44ـ أسباب وعوامل انحطاط المجتمعات.
45ـ أهميّة القيادة الدينية في المجتمع.
46ـ حقوق أفراد المجتمع على بعضهم.
47ـ الأصول الحاكمة على المجتمعات.
48ـ الصراعات الاجتماعية.
49ـ خصائص المجتمعات المنحطّة.
50ـ طرق النجاة من المفاسد الاجتماعية.
51ـ المجتمع المطلوب.
52ـ شروط قادة المجتمع.
53ـ الضرورات الاجتماعية.
54ـ وظائف الأفراد تجاه قادة المجتمع.
55ـ العوامل الاجتماعية لظهور الإمام المهدي#.
أشار الإمام الحسين× في قيامه ضدّ يزيد بن معاوية إلى وظائف الحاكم الإسلامي وميزاته، كما أشار إلى خصائص الحاكم الظالم والمستبد، لذا أفردنا لهذه الأحاديث باباً خاصاً للبحث فيها تحت العناوين التالية:
1ـ الحكام الإلهيون.
2ـ أنواع الحكام.
3ـ خصائص حكام الكفر.
4ـ عهد الله وميثاقه مع الحكومات.
5ـ وظائف الحكام.
6ـ مكانة الحكومة في الإسلام.
7ـ خصائص الحكام الغافلين.
8ـ سلبيات الحكومة.
9ـ وظائف الناس تجاه الحكام.
10ـ أركان الحكومة.
11ـ أهداف الحكومة في الإسلام.
12ـ عوامل ضعف أركان الحكومة.
13ـ عوامل تعزيز أركان الحكومة.
14ـ ضرورة الحكومة.
15ـ الأحزاب.
16ـ الحكومات الباطلة.
17ـ شروط الحكام.
18ـ العبادات السياسية.
19ـ البدع السياسية.
20ـ آثار الحكومات الباطلة.
21ـ الوصايا السياسية.
22ـ تأثير القادة على مقرّبيهم.
23ـ أهمية القيادة في الإسلام.
24ـ المنافسات السياسية.
25ـ دور البيعة في تعيين الحاكم.
26ـ الصمت السياسي.
27ـ التهم السياسية.
28ـ المكر السياسي.
29ـ شؤون الحاكم.
30ـ وظائف ممثلي الحاكم.
31ـ القيادة والناس.
أخذت بعض أحاديث الإمام الحسين× منحىً حقوقياً، فأشارت إلى حقوق الطبقات المختلفة من المجتمع ضمن الموضوعات التالية:
1ـ الحقوق الإلهية.
2ـ حقوق الأنبياء.
3ـ حقوق أهل البيت^.
4ـ حقوق الإمام.
5ـ حقوق الأولياء.
6ـ حقوق الناس على بعضهم.
7ـ حقوق الأسرة.
8ـ حقوق الحاكم على الرعية.
9ـ حقوق الرعية على الحاكم.
10ـ حقوق العالم على الجاهل.
11ـ حقوق الجاهل على العالم.
12ـ حقوق الأخوّة الإيمانية.
13ـ حقوق المواطنة.
14ـ حقوق المهاجرين.
15ـ حقوق العدو.
16ـ حقوق المرأة.
17ـ حقوق الشهيد.
18ـ حقوق الخيّرين.
19ـ حقوق الحيوانات.
20ـ حقوق الدولة.
21ـ حقوق البشر.
22ـ الحقوق الدولية.
23ـ الحقوق المعنوية.
24ـ حقوق المارّة.
25ـ حقوق المعوّقين.
26ـ حقوق المقاتلين.
27ـ حقوق المستضعفين.
28ـ حقوق المدافعين عن المقدّسات.
29ـ حقوق المخالف.
30ـ حقوق القائد.
31ـ حقوق الجندي.
32ـ حقوق العبيد.
33ـ حقوق الأموات.
34ـ حقوق الكبار.
35ـ حقوق العامل.
36ـ حقوق المريض.
37ـ حقوق الإنسان على نفسه.
38ـ حقوق الضيوف.
39ـ حقوق الأيتام.
40ـ حقوق المأموم على الإمام.
41ـ حقوق الطفل.
42ـ حقوق الأسرى.
43ـ حقوق المستشار.
44ـ حقوق الشباب.
45ـ حقوق المجرمين.
46ـ حقوق الفقراء.
47ـ حقوق الجيران.
48ـ حقوق العشيرة.
49ـ غاصبو حقوق الناس.
50ـ أهميّة الحقوق.
51ـ التنازل عن الحق في بعض الأمور.
52ـ عقوبة ترك الحقوق.
53ـ تساوي الحقوق.
54ـ الحقوق الخيالية.
55ـ الحقوق المهضومة.
56ـ أنواع الحقوق.
57ـ الحق يأخذ.
39 ـ الطبّ
تناولت بعض الروايات الواردة عن سيّد الشهداء× شيئاً من علم الطبّ ونظام خلقة الإنسان خاصة ما ورد في طليعة دعاء عرفة، لذا قمنا بجمعها في هذا الباب ومقارنتها مع باقي الروايات ومع علم الطبّ الحديث، وذلك ضمن العناوين التالية:
1ـ الصحة والسلامة.
2ـ المرض.
3ـ الأعضاء والجوارح.
4ـ الأعضاء والجوارح الظاهرية:
أ) العين
ب) الجبهة
ج) الأنف
د) الأذن
ﻫ) الشفاه
و) الرقبة
ز) الصدر
ح) اليد
ط) الأصابع
ي) الجلد
ك) الشعر
ل) الرجل
م) العضلة
5ـ الأعضاء والجوارح الباطنية.
6ـ قوى الإنسان.
7ـ النوم واليقظة.
8ـ خواصّ الأدوية.
9ـ الوصايا الطبّية.
10ـ العلاج بالدعاء.
11ـ آثار قوى الإنسان.
12ـ آثار الأعضاء والجوارح الظاهرية.
13ـ آثار الأعضاء والجوارح الباطنية.
14ـ أنواع المرض.
15ـ أساليب علاج المرضى.
16ـ العلاج بالدواء.
17ـ الأوقات التي يجب فيها الذهاب إلى الطبيب.
18ـ العوامل المؤثرة في الوقاية من المرض.
19ـ العوامل الوراثية.
20ـ عوامل قصر العمر.
21ـ خلوّ الإنسان من النقص.
22ـ وظائف الإنسان تجاه خلقته الكاملة.
هناك اختلاف في ماهية الشيطان والملائكة والجن، هل هي من المجردات أم من الماديات؟ فعدّتها الفلاسفة من المجردات الناقصة. وقد أشارت الروايات والأدعية الإسلامية بما في ذلك أحاديث الإمام الحسين× إلى هذه الموجودات الثلاثة التي يتمّ البحث عنها في هذا الباب ضمن المواضيع التالية:
1ـ المجردات.
2ـ الشيطان.
3ـ الملائكة.
4ـ الجن.
علم الفلك والنجوم من العلوم المتداولة بين البشر منذ القدم وما زال يحظى بالاهتمام البالغ ويأخذ بالتطوّر يوماً بعد يوم، وقد تطرّقت الروايات الإسلامية إلى مباحث هذا العلم بما في ذلك أحاديث سيّد الشهداء×؛ لذا أفردنا باباً مستقلاً لشرح موضوعاته التي هي:
1ـ العالم.
2ـ حدوث العالم.
3ـ السماء.
4ـ النجوم.
5ـ الشمس.
6ـ القمر.
7ـ النيازك.
8ـ حوادث الدهر.
9ـ عالم المثال.
42 ـ البيئة
نتطرّق في هذا الفصل إلى شرح روايات الإمام الحسين× التي أشار فيها إلى البيئة والعوامل المؤثرة في الطبيعة ضمن العناوين التالية:
1ـ الأشجار.
2ـ الجبال.
3ـ الماء.
4ـ السحاب.
5ـ الأرض.
6ـ الجوّ.
7ـ الرياح.
8ـ الرعد والبرق.
9ـ المطر.
10ـ البحر.
11ـ الحيوانات.
43 ـ علم النفس
(علم النفس) من العلوم المتداولة في الجامعات والذي يحتوي على موضوعات متعددة يمكننا أن نتطرّق إلى بعضها من خلال ما ورد في أحاديث سيّد الشهداء× وتطبيقها على علم النفس المعاصر وذلك ضمن المباحث التالية:
1ـ نفس الإنسان.
2ـ نفس الطفل.
3ـ الموروثات في الإنسان.
4ـ حاجات الروح والنفس.
5ـ ميول الإنسان.
6ـ الروح الإنسانية.
7ـ لذّات النفس.
8ـ ضمير الإنسان.
9ـ النزعات الغريزية لدى الإنسان.
10ـ الحالات الروحية والنفسية الإيجابية.
11ـ موانع نموّ النفس وكمالها.
12ـ موانع نجاح ورقيّ الإنسان.
13ـ عوامل نجاح الإنسان.
14ـ القوّة الحافظة.
15ـ اليقين وآثاره.
16ـ النوم واليقظة.
17ـ اطمئنان النفس والروح.
18ـ العوامل المؤثرة في طمأنينة النفس.
19ـ أوضاع النفس السلبية.
20ـ وظائف الإنسان تجاه نفسه.
21ـ المدد الإلهي للمرضى النفسيين.
22ـ الأمراض الروحية والنفسية.
23ـ تأثير المرض النفسي على الجسد.
24ـ موانع طمأنينة النفس.
25ـ تأثير الأمور الغيبية في إصلاح الروح والنفس.
26ـ أسباب الأمراض الروحية والنفسية.
27ـ الآثار الإيجابية لبعض الحالات النفسية.
28ـ عدم ثبات الحالات النفسية للإنسان.
29ـ مضارّ الحالات النفسية.
30ـ ضرورة إصلاح الإنسان لحالاته النفسية.
31ـ علائم معرفة الحالات النفسية.
32ـ تأثير الحالات النفسية.
(علم الإنسان) من العلوم التي حظيت باهتمامٍ خاصٍ في الآونة الأخيرة، فأخذ العلماء في البحث والتحقيق والتنظير فيه، وألّفوا كتباً بخصوصه، وما ذلك إلّا لأهميته البالغة التي سبق وأن تطرّق أهل البيت^ لها بما فيهم الإمام الحسين× حيث أشار في كلماته إلى بعض مواضيع هذا العلم من قبيل:
1ـ حقيقة الإنسان.
2ـ متطلّبات الإنسان.
3ـ منزلة الإنسان.
4ـ ارتباط الإنسان بالله تعالى.
5ـ تكامل الإنسان.
6ـ العناية الإلهية بالإنسان.
7ـ اختيار الإنسان.
8ـ قوى الإنسان.
9ـ هداية الإنسان.
10ـ موانع نموّ الإنسان.
11ـ تربية الإنسان.
12ـ ميول الإنسان.
13ـ امتحان الإنسان.
14ـ سعادة الإنسان وشقاوته.
15ـ حياة الإنسان.
16ـ ارتباط الإنسان بنوعه.
17ـ ارتباط الإنسان بنفسه.
18ـ بلوغ الإنسان.
19ـ علم الإنسان وجهله.
20ـ نقاط ضعف الإنسان.
21ـ طبيعة الإنسان.
22ـ فطرة الإنسان.
23ـ طبيعة الإنسان المشتركة.
24ـ علاقة الله بالإنسان.
25ـ روح الإنسان.
26ـ نفس الإنسان.
27ـ وظائف الإنسان.
28ـ خلقة الإنسان.
29ـ حرية الإنسان.
30ـ الأمور المؤثّرة في روح وجسم الإنسان.
31ـ ميزات الإنسان.
من الأمور التي تطرّق لها الإمام الحسين× في أحاديثه الدنيا ومدى تأثيرها على الإنسان في الدّارين، لذا أفردنا لشرح هذه الأحاديث فصلاً خاصاً مستندين إلى الآيات والروايات المؤيّدة لمضمون ما نحن فيه، وذلك ضمن العناوين التالية:
1ـ قيمة الدنيا.
2ـ حقيقة الدنيا.
3ـ خصائص الدنيا.
4ـ حياة الأولياء الدنيوية.
5ـ نظرة الأولياء للدنيا.
6ـ متاع الدنيا وملذّاتها.
7ـ مضارّ الدنيا.
8ـ مواقع الإنسان ومواقفه في الدنيا.
9ـ كيفية حياة الإنسان في الدنيا.
10ـ حوادث الدنيا.
11ـ أنواع الحياة الدنيوية.
12ـ تأمين حياة الإنسان في الدنيا.
13ـ العقوبات الدنيوية.
14ـ الدرجات الدنيوية.
15ـ وظائف الإنسان في الدنيا.
16ـ آثار الدنيا وطلبها.
17ـ نمط الحياة الدنيوية.
18ـ حاجات الإنسان الدنيوية في الدنيا.
19ـ مرارة الحياة الدنيوية.
20ـ خصائص عبدة الدنيا.
21ـ عوامل النجاة من الشدائد في الدنيا.
22ـ أسباب الراحة والرفاهية.
23ـ إمكان الحياة السعيدة في الدنيا.
24ـ محبّو الخير في الدنيا.
25ـ وظيفة الإنسان عند الشدائد.
26ـ الفرج بعد الشدّة.
27ـ آثار ابتلاءات الدنيا.
28ـ عوامل إعراض الدنيا عن الإنسان.
29ـ عوامل إقبال الدنيا على الإنسان.
30ـ وظائف الإنسان حين إقبال الدنيا عليه.
31ـ آثار الابتعاد عن الدنيا.
32ـ عوامل تفاهة الدنيا.
33ـ نسبة الدنيا إلى الآخرة.
46 ـ حقوق الطفل
أشار الإمام الحسين× في بعض أحاديثه وخطاباته إلى حقوق الأطفال والناشئة والبالغين، ونظراً لكثرة المباحث المتعلّقة بحقوق الطفل أفردنا لها باباً للبحث فيها بصورة خاصة ضمن العناوين التالية:
1ـ تكوين الجنين.
2ـ مبدأ تكوين الجنين.
3ـ سلامة خلق الجنين.
4ـ رغبات الرضيع عند بكائه.
5ـ ما يحتاجه الطفل.
6ـ عناية الله بالطفل.
7ـ أنواع الأمهات.
8ـ الطفل عرضة للأمراض.
9ـ وظائف الأم تجاه الطفل.
10ـ فترة الرضاع.
11ـ خصائص حليب الأم.
12ـ وظائف الممرّضات تجاه الطفل.
13ـ مفهوم بكاء الطفل.
14ـ نموّ الطفل.
15ـ نعمة الولد.
16ـ حاجة الإنسان للولد.
17ـ شعور الطفل.
18ـ فطرة الطفل.
19ـ كرامة الطفل.
20ـ تربية الطفل.
21ـ أيام الطفولة.
22ـ الفتيان المحظوظون.
23ـ عطف الوالدين على الطفل.
24ـ النزعات التوحيدية لدى الطفل.
25ـ نفسية الطفل.
26ـ وظيفتنا تجاه إيمان الطفل.
27ـ عبادات الطفل.
47 ـ معرفة العدو
تُعدّ معرفة العدو من أهم وظائف المسلمين على مرّ التاريخ الإسلامي، وقد أكّد الإمام الحسين× على هذا الأمر بصورة كبيرة، الأمر الذي دفعنا إلى فتح بابٍ خاص للبحث والخوض في مواضيع معرفة العدو من قبيل:
1ـ أصالة عدم العداوة.
2ـ وظائفنا تجاه العدو.
3ـ خصائص الأعداء.
4ـ حقوق العدو.
5ـ الأمور المؤثرة في انقياد العدو.
6ـ تكتيكات مواجهة العدو.
7ـ خطط العدو ووسائله.
8ـ شروط المواجهة مع العدو.
9ـ عقاب العدو.
10ـ ما يمكن طلبه من العدو.
11ـ أنواع الأعداء.
12ـ إعلام العدو وتأثيره.
13ـ إمهال الله للأعداء.
14ـ عوامل تسلّط العدو على الناس.
15ـ أهداف العدو من بغضه لأولياء الله.
16ـ رايات العداوة.
17ـ خصائص العارفين بالأعداء.
48 ـ مقارعة الظلم
من المواضيع المهمّة التي أكّد عليها سيّد الشهداء× في أحاديثه وخطاباته مقارعة الظلم والوقوف بوجه الاستكبار، الأمر الذي دعانا للخوض في هذا الموضوع بصورة خاصة ضمن العناوين التالية:
أ) الظالم:
1ـ العناصر المشتركة بين الظالم والمظلوم.
2ـ إجراءات الظلمة بحقّ المظلومين.
3ـ ابتهاج الظالمين.
4ـ منهج الظلمة.
5ـ ملاجئ الظلمة.
6ـ كيف يُعامل الله الظالمين؟
7ـ مواقف الظلمة تجاه الله سبحانه.
8ـ أنواع الظلمة.
9ـ خصائص الظلمة.
10ـ ردود فعل الناس تجاه الظلمة.
11ـ أسباب عدم نهي الظلمة عن المنكر.
12ـ أهداف الظلمة.
13ـ الذين يتركون مقارعة الظلمة.
14ـ أنواع الخروج على الحكام الظلمة.
15ـ شروط الخروج على الحاكم الظالم.
16ـ أعوان الظالم.
ب) المظلوم:
1ـ الذين وقع عليهم الظلم.
2ـ الله تعالى معين المظلومين.
3ـ وظيفة المظلومين.
4ـ أنواع المظلومين.
5ـ حاجات المظلومين.
6ـ سبيل نجاة المظلومين.
7ـ مُعين المظلوم.
8ـ مصالح المظلومين.
9ـ ردود فعل المظلومين على الظلم.
10ـ الوعود الإلهية للمظلومين.
11ـ معاناة المظلومين في حكومة الظالمين.
ج) الظلم:
1ـ مراتب الظلم.
2ـ أسباب ظلم المظلومين.
3ـ إمكان النجاة من الظلم.
4ـ آثار الظلم.
5ـ حرمة الظلم.
د) وظائفنا تجاه الظالمين.
1ـ وظيفتنا إزاء الظلم.
2ـ وظيفة من يريد الإطاحة بحكومة الظالم.
3ـ وظيفتنا تجاه من أطاحوا بحكومة الظالم.
4ـ وظيفتنا تجاه أعوان الظالم.
ﻫ) المناضل السياسي:
1ـ موقف المناضلين السياسيين.
2ـ مشاكل المناضلين السياسيين.
3ـ متطلّبات المناضلين السياسيين.
4ـ معيار تشخيص الثورات ضدّ الظلمة.
5ـ ألطاف الله تعالى بالثائرين ضدّ الظلمة.
6ـ أهداف الثائرين ضدّ الظلمة.
إنّ للمناظرة وللحوار وللنقاش وكذا للمشورة والخطابة والتبليغ آداباً خاصة، ولذا تُطرح كل واحدة من هذه الاصطلاحات بعنوان فنّ خاص له قوانينه، وقد بيّنت الأحاديث الإسلامية الخطوط العريضة لهذه الفنون بما في ذلك أحاديث السبط الشهيد× التي أشارت إلى بعض المباحث من قبيل:
أ) أسلوب المناظرة:
1ـ آداب المناظرة.
2ـ أنواع الإجابة عن الأسئلة.
3ـ الجدال بالباطل.
4ـ من لا تجب مناظرتهم.
5ـ وظائف المناظر.
6ـ أنواع المناظرين.
7ـ وقت المناظرة.
ب) أسلوب التشاور:
1ـ وظائف المستشار.
2ـ وظائفنا تجاه المستشار.
3ـ حقوق المستشار.
4ـ آداب التشاور.
5ـ من وظائف قادة المجتمع.
6ـ صفات المستشار.
7ـ متى نستعين بالمستشار؟
ج) أسلوب الخطابة
1ـ فنّ الخطابة.
2ـ مكانة الخطابة.
3ـ طريقة الخطابة.
4ـ مواضع الخطابة.
5ـ أنواع الخطابة.
6ـ آداب الخطابة.
7ـ أنواع الخطيب.
8ـ وظائف الخطيب.
9ـ وظائف الناس تجاه الخطيب.
د) أسلوب التبليغ.
1ـ وظائف المسؤولين إزاء الدعاة.
50 ـ الذنب
تطرّقت الآيات القرآنية والسنّة الشريفة إلى مسألة الذنب وآثاره، والتوبة والاستغفار والمغفرة الإلهية، وعندما نراجع الروايات الواردة عن سيّد الشهداء× نجد أنّها استوفت هذه المباحث وما يتعلّق بها بصورة واسعة مما دفعنا إلى إفراد باب خاص لها في هذه الموسوعة ضمن العناوين التالية:
أ) الذنب:
1ـ مضارّ الذنب.
2ـ حاجة الإنسان للابتعاد عن الذنب.
3ـ الآثار الوضعية للذنب.
4ـ إمكان تلافي الذنب.
5ـ آثار ترك الذنوب.
6ـ أنواع الذنوب.
7ـ الإنسان مختار عند ارتكاب الذنب.
8ـ الإقالة من الذنب.
9ـ آثار الاعتراف بالذنب.
10ـ المشاركة في الذنوب.
11ـ ضرورة الاعتراف بالذنب.
12ـ العزيمة على الذنب.
13ـ عوامل الصفح عن الذنب.
14ـ الذنوب التي لا تغفر.
15ـ زمان تلافي الذنب.
16ـ أسباب الوقوع بالذنب.
17ـ الفرق بين الخطأ والذنب.
18ـ الذنب لا يضرّ الله سبحانه.
19ـ وظيفة الإنسان قبال الذنب.
20ـ درجات قبح الذنب.
21ـ الأفراد المنزّهون عن الذنب.
22ـ عوامل الابتعاد عن الذنب.
23ـ الاستغفار من الذنوب.
24ـ عذر أسوء من ذنب.
25ـ التوبة من الذنب.
26ـ المغفرة الإلهية من الذنوب.
27ـ الله هو ستّار العيوب.
28ـ عوامل المغفرة الإلهية من الذنوب.
29ـ عفو الله عن الذنوب.
30ـ كفّارة الذنوب.
ب) المذنب:
1ـ خطأ المذنب.
2ـ وظائف المذنب.
3ـ حقوق الله على المذنب.
4ـ ألطاف الله بالمذنبين.
5ـ العُصاة.
6ـ صفات المذنب.
7ـ وظائفنا تجاه المذنب.
8ـ الله تعالى شاهد على المذنب.
9ـ إتمام الحجّة على المذنب.
10ـ المذنبون الذين لا يُعذّبون.
11ـ أنواع المذنبين.
12ـ زلّة المذنب.
تحظى الفنون العسكرية هذا اليوم بأهمية بالغة، حيث تدرّس في الجامعات بصورة تخصصية وعميقة وذلك للاستفادة منها في المجال العملي إذْ يتمّ تعليمها للقادة العسكريين وللقوّات المسلّحة، وقد تطرّق الإمام الحسين× في أحاديثه إلى كثير من فنون الحرب ووظائف القادة والعسكر من قبيل المباحث التالية:
1ـ وظائف القائد العام للقوات.
2ـ وظائف قادة الجيش.
3ـ وظائف الجيش.
4ـ وظائف الحكومة إزاء العسكريين.
5ـ وظائف الناس عند اشتعال الحرب.
6ـ وظائف جيش الإسلام تجاه العدو.
7ـ الأمور المؤثرة في رفع معنويّات الجيش.
8ـ آثار الحرب.
9ـ الأعداء الذين يجب قتالهم.
10ـ علامات الاستعداد للحرب.
11ـ علامات عدم الاستعداد للحرب.
12ـ أنواع الحروب.
13ـ خصوصيّات جيش العدو.
14ـ الأمور المؤثرة في واقع الجيش.
15ـ المصالح العسكرية.
16ـ التكتيكات (الخطط) العسكرية.
17ـ حقوق الحرب.
18ـ الصلاحيات العسكرية.
19ـ أصول الحرب.
20ـ رجال الانتصار.
21ـ حقوق الأعداء.
22ـ شروط المواجهة مع العدو.
23ـ زمن اختبار القوات.
24ـ الأمور المؤثرة في تأجيل الحرب.
25ـ دوافع الحرب مع العدو.
26ـ الإعلام الحربي.
27ـ حقوق الجندي.
28ـ وقت الحرب.
29ـ مكانة الجندي المضحّي.
رعاية النظام في الوسط الأسري واحدة من المسائل المؤثرة في خلق نظام اجتماعي متكامل يدفع نحو بناء أمّة منسجمة إذ ستعيش فيه الأسرة وجميع أفرادها الصّحة النّفسية والأخلاقية.
وعندما نعيد النّظر فيما ورد عن الإمام الحسين× من روايات نجد أنّه قد تناول في هذا الخصوص مجموعة من العناوين مثل:
1ـ العناصر المشتركة بين الرجل والمرأة.
2ـ مسائل الأسرة.
3ـ أنواع الأسر.
4ـ وظائف الإنسان تجاه أسرته.
5ـ المشاكل الأسرية.
6ـ حرمة الأسرة.
7ـ الآداب الإسلامية للأسرة.
8ـ المصائب الأسرية.
9ـ انتساب الولد إلى الأسرة.
10ـ وظائف الإنسان بالنسبة إلى النظام الأسري.
11ـ وظائف الأولاد.
12ـ أنواع الأولاد.
13ـ قيمة الأولاد.
14ـ التدابير الإلهية لحفظ ذريّة الإنسان.
15ـ أنواع النسب.
16ـ أنواع الإخوان.
17ـ وظائف الزوج تجاه زوجته.
18ـ وظائف الإنسان عند الزواج.
19ـ وظائف الإنسان تجاه ولده.
20ـ وظائف الإنسان تجاه أقاربه.
21ـ من صلاحيات المرأة.
22ـ صلة المرأة بالرجل.
23ـ خصائص المرأة.
24ـ حقوق النساء.
25ـ مساواة حقوق النساء.
26ـ حقوق الأب.
27ـ حقوق الأم.
28ـ حقوق الرجل على المرأة.
29ـ حقوق الأب والأم على الولد.
30ـ الأقارب النسبيين والسببيين.
31ـ التشابه العائلي.
32ـ نعمة الولد السالم.
33ـ آثار خدمة الأب.
34ـ الجبر الوراثي.
35ـ الحكم على الرجال بالباطل.
من الأبحاث والموضوعات الهامة التي طفت على السطح بعد ما اشتعلت الثورات والنهضات في المنطقة الإسلامية خلال السنوات العشر الأخيرة، وعرفت بالصحوة الإسلامية، رغم أنّ الكثير منها كانت غير ناجحة ولم تثمر عن شيء، ويعود السبب وراء ذلك إلى عدم إدارتها بصورة حكيمة وعدم اعتمادها أسساً ومبادئ رصينة، بيد أنّنا إذا تأمّلنا في نهضة الإمام الحسين× بنظرة دقيّة سنجد أنّه× ونتيجة رعايته لمجموعة من الأمور قد انتصر وأيّ انتصار! وإن بدا ذلك بمرور الزمان وتقادمه، ومن الممكن لنا أن نلخّصها بما يلي:
1ـ الدعوة.
2ـ الدعوة للتعقّل والتفكّر.
3ـ الحث على حرية التفكير.
4ـ رفض التعسّف والعنف.
5ـ التعويل على القدرات الخاصة.
6ـ الاعتماد على الشباب.
7ـ الحوار.
8ـ حسن الظن بمن معه
9ـ روح التضحية والفداء.
10ـ الإحسان.
11ـ الحركة المعاكسة.
12ـ الاستعانة بالخطابة.
13ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
14ـ عنصر المظلومية.
15ـ الشفافية.
16ـ استغلال الفُرَص.
17ـ الحركة ضمن الإطار الشرعي.
18ـ فهم العدو.
19ـ التعريف الدقيق للعدو.
20ـ السير على خُطى الأولياء.
21ـ الدفاع بدل الهجوم.
22ـ الاستعانة بقوى متحفّزة.
23ـ الاستفادة من طبقات مختلفة.
24ـ الإخلاص.
25ـ العمل المنظّم الممنهج.
26ـ التركيز على المسائل الأساسية في الإسلام.
27ـ مقارعة الظلم.
28ـ بيان المواقف المبدئية.
29ـ النظرة المستقبلية.
30ـ الدفاع عن الحركة الإصلاحية.
31ـ عدم الميل للظلمة.
32ـ التعريف بمكانته.
33ـ عدم الإكراه في جمع الأصحاب.
34ـ الدفاع عن أصحابه الأوفياء.
35ـ الإحاطة بأسرار المجتمع.
36ـ إتمام الحجّة على المخالف.
37ـ اختبار القوّة.
38ـ رفع الروح المعنوية للمقاتلين.
39ـ امتلاك روحية المرونة.
40ـ عدم الاستفادة من الأساليب غير المتعارفة.
41ـ العمل بالواجب.
42ـ إثارة الأحاسيس.
43ـ عدم الخوف من الموت في سبيل الحق.
44ـ العزة والشموخ.
من الآيات التي يُستدلّ بها على ولاية وإمامة أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين× آية (أولي الأمر) حيث يقول تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)([9]).
وبما أنّ هذه الآية تدلّ على إمامة أهل البيت^ عمدنا إلى البحث حولها بصورة مختصرة.
قبل الولوج في صلب الآية الكريمة نتطرّق إلى بيان معاني مفرداتها:
المقصود من طاعة الله هو العمل بالتعاليم والأحكام التي نزلت وحياً على قلب رسول الله|، والتي شمل خطابها عامّة المكلّفين؛ وعليه فإنّ طاعة الله تعالى بمعنى اتّباع وحيه المسطور بين دفّتي القرآن الكريم.
تتحقق الطاعة لرسول الله| بثلاثة أمور:
1ـ طاعته| في تفصيل وتوضيح الأحكام التي أوحيت إليه، ولم ترد في القرآن الكريم؛ لأنّ ما جاء في القرآن عبارة عن القواعد العامّة للأحكام التي تتطلّب بيان النبي| وتوضيحه، لذا يقول تعالى:
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ([10]).
2ـ طاعته| في الأمور التشريعية التي أوكلت إليه، إذ هناك ثمّة أدلّة تثبت أنّ بعض الأحكام أوكل تشريعها لرسول الله|، كما جاء في إضافة عدد الركعات من قبل النبي| بعد تشريع الصلوات بالركعتين.
يقول الشيخ الصدوق:
«وَقَالَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ×: كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ} عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَفِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَلَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ ـ يَعْنِي سَهْوٌ ـ فَزَادَ رَسُولُ الله| سَبْعاً وَفِيهِنَّ السَّهْوُ، وَلَيْسَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ، فَمَنْ شَكَّ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ أَعَادَ حَتَّى يَحْفَظَ وَيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ، وَمَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ»([11]).
3. طاعته| في الآراء الخاصة والأمور الاجتماعية التي ترتبط بمهامّ الوالي والحاكم الإسلامي لأجل إرساء دعائم الحكومة الإسلامية، يقول تعالى:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)([12]).
فعلى جميع المسلمين الامتثال والطاعة لرسول الله| في الموارد الثلاثة التي تمّ بيانها، وأن يدركوا بأنّ طاعته| إنّما هي طاعة الله}.
(أولي الأمر) هم الأئمّة المعصومون من أهل البيت^ وهذا ما سنثبته لاحقاً بحوله تعالى، أمّا بحثنا الآن فهو في سعة طاعة أولى الأمر وحدودها، وما هي الأمور التي يجب طاعتهم فيها؟
1ـ ذهب بعض العلماء إلى أنّ الأئمة^ ليس لهم حقّ التشريع، ومهمّتهم الوحيدة في البعد التشريعي التوضيح والتبيين لأحكام الشريعة التي ذُكرت من قبل رسول الله| والتي تتطلب البسط والتبيين والتطبيق الصحيح، فعلى الناس الطاعة والعمل بما يبيّنه أئمة أهل البيت^ في هذا المجال.
روى عبد الله بن عجلان عن الإمام الباقر× في تفسير الآية الكريمة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) أنّه قال:
«هِيَ فِي عَلِيٍّ وَفِي الْأَئِمَّةِ، جَعَلَهُمُ اللهُ مَوَاضِعَ الْأَنْبِيَاءِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يُحِلُّونَ شَيْئاً، وَلَا يُحَرِّمُونَهُ»([13]).
2ـ من الأمور الأخرى التي يجب فيها طاعة أهل البيت^ القوانين المرتبطة بالنظام الإسلامي وحفظ شؤون الدولة الإسلامية، فعند صدور الأحكام الولائية منهم^ بهذا الخصوص يجب على جميع المسلمين الطاعة والامتثال، سواء كان في زمن حكومتهم^ أو لا.
اختلفت الآراء في المقصود من (أولي الأمر) في الآية فوردت أقوال عديدة في ذلك منها:
1ـ أمراء رسول الله|.
2ـ الأمراء بصورة عامّة.
3ـ أصحاب رسول الله|.
4ـ المهاجرون والأنصار.
5ـ الصحابة والتابعون.
6ـ العلماء.
7ـ أمراء السرايا.
8ـ أئمة أهل البيت^.
9ـ خصوص أهل البيت^.
10ـ الخلفاء الأربعة.
11ـ أبو بكر وعمر.
12ـ كل من تولّى أمور المسلمين بطريق صحيح.
13ـ الأمراء بالحق.
14ـ علماء الدين.
15ـ الإجماع.
16ـ الإمام المعصوم([14]).
سنثبت لاحقاً أنّ القول الأخير هو الرأي الصواب وذلك من خلال إثبات العصمة لـ (أولي الأمر).
عند التأمّل في آية (أولي الأمر) نصل إلى نتيجة مفادها ضرورة اتصاف أولي الأمر بالعصمة، يقول الفخر الرازي:
«أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ، إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنّه محال، فثبت أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنّ كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أنّ أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بدّ وأن يكون معصوماً»([15]).
على رغم مسايرة الفخر الرازي للشيعة بانطباق (أولي الأمر) على الأفراد المعصومين إلّا أنّه أخطأ في تعيين المصداق، فجعل أهل الحلّ والعقد في الأمّة مصداقاً للآية الكريمة([16]).
كما أنّ آيات القرآن الكريم تفسّر بعضها بعضاً، كذلك الروايات يمكنها أن تفسّر الآيات القرآنية وتبيّنها، لذا يقول تعالى:
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ([17]).
هناك روايات بإمكانها أن تبيّن لنا مصداق أولي الأمر في الآية الكريمة، من قبيل:
روى البخاري بسنده عن جابر بن سمرة عن النبي|:
«يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً، فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([18]).
كلمة (أمير) من مادة أمر وإمارة، كما تفيدنا هذه الرواية في وضع الإطار العام لعدد (أولي الأمر) وأنّهم اثنا عشر فحسب.
2 ـ حديث إطاعة رسول اللّه|في إطاعة علي×
روى الحاكم النيسابوري بسند صحيح عن رسول الله| قوله:
«مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيّاً فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى عَلِيّاً فَقَدْ عَصَانِي»([19]).
يبيّن الرسول الكريم في هذا الحديث أنّ طاعة علي× ملازمة لطاعته|، وأنّ طاعته ملازمة لطاعة الله، وهذا هو المعنى الذي تشير إليه الآية الكريمة.
روى الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله:
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي)»([20]).
يشير هذا الحديث أيضاً إلى لزوم التمسك بعترة النبي| وطاعتهم.
تدلّ أحاديث الشيعة الإمامية سواء بالتواتر الإجمالي أو بالسند الصحيح على أنّ مصداق (أولي الأمر) هم أهل البيت^، كما توافق بأجمعها دلالة الآيات الكريمة، الأمر الذي دعا لقبول هذه الأحاديث من قبل العلماء، وعلى رغم التنوّع الموجود لا يوجد فيها أيّ تعارض.
قال جابر:
«لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ} عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّد| ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَرَفْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ فَمَنْ أُولُو الْأَمْرِ الَّذِينَ قَرَنَ اللهُ طَاعَتَهُمْ بِطَاعَتِكَ؟ فَقَالَ×: هُمْ خُلَفَائِي يَا جَابِرُ، وَأَئِمَّةُ المسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِي، أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ الحسَنُ وَالحسَيْنُ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ الحسَيْنِ، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ المعْرُوفُ فِي التَّوْرَاةِ بِالْبَاقِرِ، وَسَتُدْرِكُهُ يَا جَابِرُ، فَإِذَا لَقِيتَهُ فَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ، ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، ثُمَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثُمَّ سَمِيِّي وَكَنِيِّي حُجَّةُ اللهِ فِي أَرْضِهِ وَبَقِيَّتُهُ فِي عِبَادِهِ ابْنُ الحسَنِ بْنِ عَلِيٍّ؛ ذَاكَ الَّذِي يَفْتَحُ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى يَدَيْهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا...»([21]).
كما ورد في خطبةٍ للإمام الحسن× بعد مبايعة الناس له:
«فَأَطِيعُونَا فَإِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةٌ إِذْ كَانَتْ بِطَاعَةِ اللهِ} وَرَسُولِهِ مَقْرُونَةً، قَالَ}: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)»([22]).
وروى عن الإمام الباقر×:
«إِيَّانَا عَنَى خَاصَّةً، أَمَرَ جَمِيعَ المؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِطَاعَتِنَا»([23]).
وكذا ما ورد عن الإمام الباقر× وهو يفسّر (أولي الأمر) بأهل البيت^ وأنّ طاعتهم هي طاعة الله يقول:
«وَهُمُ المعْصُومُونَ المطَهَّرُونَ الَّذِينَ لَا يُذْنِبُونَ وَلَا يَعْصُونَ... وَلَا يُفَارِقُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يُفَارِقُهُمْ»([24]).
ويفسّر الإمام الرضا× تعبير (أولي الأمر) الوارد في الآية بقوله:
«الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ÷ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»([25]).
جاء في روايات أهل السنّة أيضاً أنّ المراد من (أولي الأمر) في الآية الكريمة هم الأئمة من أهل البيت^.
روى الحاكم الحسكاني بسنده عن الإمام علي× عن رسول الله| أنّه قال:
«شُرَكَائِي الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللهُ بِنَفْسِهِ وَبِي وَأَنْزَلَ فِيهِم: () يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) الْآيَةَ، فَإِنْ خِفْتُمْ تَنَازُعاً فِي أَمْرٍ فَارْجِعُوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَنْتَ أَوَّلُهُمْ»([26]).
وروى الحموي بسنده في حديث طويل أنّ الإمام علي× قال لبعض الصحابة مخاطباً:
«فَأَنْشُدُكُمُ اللهَ أَتَعْلَمُونَ حَيْثُ نَزَلَتْ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)... قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ خَاصَّةٌ فِي بَعْضِ المؤْمِنِينَ أَمْ عَامَّةٌ لِجَمِيعِهِمْ؟ فَأَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ يُعَلِّمَهُمْ وُلَاةَ أَمْرِهِمْ وَأَنْ يُفَسِّرَ لَهُمْ مِنَ الْوَلَايَةِ مَا فَسَّرَ لَهُمْ مِنْ صَلَاتِهِمْ وَزَكَاتِهِمْ وَحَجِّهِمْ. فَينْصِبُنِي لِلنَّاسِ بِغَدِيرِ خُمٍّ...»([27]).
الإمام الحسين× أحد مصاديق (أولي الأمر) الذين أمر الله تعالى بطاعتهم.
من الأحاديث المتواترة والصحيحة عند الفريقين الشيعة وأهل السنّة أحاديث اثني عشر إماماً وخليفة، وهي الروايات التي بيّن فيها النبي| الأئمة والخلفاء بالحق من بعده وأكّد فيها بأنّ عددهم اثنا عشر إماماً بما فيهم الإمام الحسين×.
أ) الأحاديث الواردة عن طرق السنّة
روى أهل السنّة في صحاحهم ومسانيدهم عن جابر بن سمرة وغيره أحاديث (الاثني عشر خليفة) بأسانيد صحيحة. وقد نالت اهتماماً بالغاً من جميع الفرق الإسلامية حتّى وصلت إلى درجة لا يعتريها الشك والشبهة. نشير هنا إلى بعضها:
1ـ روى البخاري بسنده عن جابر بن سمرة أنّ النبي| قال:
«(يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيراً)، فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([28]).
2ـ روى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة قال:
«دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً). قَالَ: ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ خَفِيَ عَلَيَّ. قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([29]).
3ـ وكذا روى مسلم بسنده عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله| يقول:
«(لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِياً مَا وَلِيَهُمْ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً)، ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ، فَسَأَلْتُ أَبِي: مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؟ فَقَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([30]).
4ـ وكذا روى بسنده عن جابر بن سمرة أنّه سمع من رسول الله|:
«(لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً)، ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ فَقَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([31]).
5ـ وأيضاً روى بسنده عن جابر بن سمرة أنّه قال:
«انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَمَعِي أَبِي، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزاً مَنِيعاً إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً)، فَقَالَ كَلِمَةً صَمَّنِيهَا النَّاسُ، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([32]).
6ـ عامر بن سعد بن أبي وقّاص يقول:
«كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ: أَنْ أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمَ جُمُعَةٍ، عَشِيَّةَ رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ، يَقُولُ: (لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِماً حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([33]).
7ـ وروى الطبراني بسنده عن جابر بن سمرة أنّه قال:
«كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ: (يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ قَيِّماً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ) ثُمَّ هَمَسَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا الْكَلِمَةُ الَّتِي هَمَسَ بِهَا النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؟ قَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([34]).
8ـ وأيضاً روى بسنده عن جابر بن سمرة أنّ النبي| قال في حجّة الوداع:
«لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ ظَاهِراً عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرَّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مفَارِقٌ حَتَّى يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ»([35]).
9ـ وروى أحمد بن حنبل أيضاً بسنده عن جابر بن سمرة قوله:
«خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزاً مَنِيعاً ظَاهِراً عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ)، قَالَ: فَلَمْ أَفْهَمْ مَا بَعْدُ، قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ؟ قَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([36]).
10ـ كما روى أيضاً بسنده عن جابر بن سمرة أنّ رسول الله| خطبنا في عرفات ـ وعلى قول آخر في منى ـ فقال:
«لَنْ يَزَالَ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزاً ظَاهِراً حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ، ثُمَّ لَغَطَ الْقَوْمُ، وَتَكَلَّمُوا، فَلَمْ أَفْهَمْ قَوْلَهُ بَعْدَ: (كُلُّهُمْ)، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتَاهُ مَا بَعْدَ (كُلُّهُمْ)؟ قَالَ: (كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ)»([37]).
11ـ وروى أيضاً بسنده عن جابر بن سمرة عن النبي| أنّه قال:
«لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزاً مَنِيعاً، يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً، قَالَ: فَجَعَلَ النَّاسُ يَقُومُونَ وَيَقْعُدُونَ»([38]).
ب) الأحاديث الواردة عن طرق الشيعة
وردت أحاديث عن طرق الشيعة بنفس المضمون الوارد في أحاديث أهل السنّة، من قبيل:
1ـ روى الشيخ الصدوق بسنده عن عبد الله بن عباس أنّ رسول الله| قال:
«أَنَا سَيِّدُ النَّبِيِّينَ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ، وَإِنَّ أَوْصِيَائِي بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ، أَوَّلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَآخِرُهُمُ الْقَائِمُ»([39]).
2ـ سأل أعرابي رسول الله| قائلاً:
«... فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَكُونُ بَعْدَكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: لَا أَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وَلَكِنْ يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَوَّامُونَ بِالْقِسْطِ كَعَدَدِ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ...»([40]).
3ـعن السيّدة الزهراء‘:
«سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ| يَقُولُ: الْأَئِمَّةُ بَعْدِي عَدَدَ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ»([41]).
4ـ قال الإمام علي× في حديث طويل:
«... فَإِنَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً هَادِينَ مَهْدِيِّينَ لَا يَضُرُّهُمْ خِذْلَانُ مَنْ خَذَلَهُمْ»([42]).
5ـ قال الأصبغ بن نباتة:
«سَمِعْتُ الحسَنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: الْأَئِمَّةُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ| اثْنَا عَشَرَ، تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ أَخِيَ الحسَيْنِ، وَمِنْهُمْ مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ»([43]).
6ـ وعن الإمام السجاد×:
«إِنَّ اللهَ خَلَقَ مُحَمَّداً وَعَلِيّاً وَأَحَدَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِهِ مِنْ نُورِ عَظَمَتِهِ، فَأَقَامَهُمْ أَشْبَاحاً فِي ضِيَاءِ نُورِهِ يَعْبُدُونَهُ قَبْلَ خَلْقِ الخلْقِ، يُسَبِّحُونَ اللهَ وَيُقَدِّسُونَهُ وَهُمُ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللهِ|»([44]).
7ـ قال زرارة:
«سَمِعْتُ أَبَا جَعْفرٍ× يَقُولُ: نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْهُمْ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ ثُمَّ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الحسَيْنِ×»([45]).
8ـ قال الإمام الصادق×:
«مِنَّا اثْنَا عَشَرَ مَهْدِيّاً»([46]).
أشارت الأحاديث بأجمعها إلى إمامة وخلافة اثني عشر شخصاً بعد رسول الله|، ولا يمكن حملها إلّا على الأئمة الاثني عشر من أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين×.
يقول القندوزي الحنفي في هذا المقام:
«قال بعض المحققين: إنّ الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده| اثنا عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة، فبشرح الزمان وتعريف الكون والمكان، علم أنّ مراد رسول الله| من حديثه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته وعترته، إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه، لقلّتهم عن اثني عشر، ولا يمكن أن يحمله على الملوك الأموية لزيادتهم على اثني عشر، ولظلمهم الفاحش إلّا عمر بن عبد العزيز، ولكونهم غير بني هاشم؛ لأنّ النبي| قال: (كلّهم من بني هاشم) في رواية عبد الملك عن جابر، وإخفاء صوته| في هذا القول يرجح هذه الرواية؛ لأنّهم لا يحسنون خلافة بني هاشم، ولا يمكن أن يحمله على الملوك العباسية لزيادتهم على العدد المذكور، ولقلّة رعايتهم الآية (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) وحديث الكساء، فلا بدّ من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثني عشر من أهل بيته وعترته|؛ لأنّهم كانوا أعلم أهل زمانهم وأجلّهم وأورعهم وأتقاهم، وأعلاهم نسباً، وأفضلهم حسباً، وأكرمهم عند الله، وكان علومهم عن آبائهم متصلاً بجدّهم| وبالوراثة واللدنية، كذا عرفهم أهل العلم والتحقيق وأهل الكشف والتوفيق.
ويؤيّد هذا المعنى، أي أنّ مراد النبي| الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته ويشهده ويرجحه حديث الثقلين، والأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب وغيرها»([47]).
3 ـ النصوص على تعيين الاثني عشر إماماً
بيّنت بعض الروايات الواردة أسماء أهل البيت^ على وجه التعيين بما فيها الروايات التالية:
1ـ روى الحموي بسنده عن ابن عباس:
«قَدِمَ يَهُودِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُقَالُ لَهُ: نَعْثَلٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ أَشْيَاءَ تَلَجْلَجُ فِي صَدْرِي مُنْذُ حِينٍ فَإِنْ أَجَبْتَنِي عَنْهَا أَسْلَمْتُ عَلَى يَدِكَ. قَالَ: سَلْ يَا أَبَا عُمَارَةَ.
... فَأَخْبِرْنِي عَنْ وَصِيِّكَ مَنْ هُوَ؟ فَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ وَصِيٌّ وَإِنَّ نَبِيَّنَا مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ أَوْصَى إِلَى يُوشَعَ بْنِ نُونٍ.
فَقَالَ: نَعَمْ إِنَّ وَصِيِّي وَالخلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ× وَبَعْدَهُ سِبْطَايَ: الحسَنُ ثُمَّ الحسَيْنُ يَتْلُوهُ تِسْعَةٌ مِنْ صُلْبِ الحسَيْنِ أَئِمَّةٌ أَبْرَارٌ.
قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَسَمِّهِمْ لِي. قَالَ: نَعَمْ إِذَا مَضَى الحسَيْنُ فَابْنُهُ عَلِيٌّ، فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ مُحَمَّدٌ، فَإِذَا مَضَى مُحَمَّدٌ فَابْنُهُ جَعْفَرٌ، فَإِذَا مَضَى جَعْفَرٌ فَابْنُهُ مُوسَى، فَإِذَا مَضَى مُوسَى فَابْنُهُ عَلِيٌّ، فَإِذَا مَضَى عَلِيٌّ فَابْنُهُ مُحَمَّدٌ ثُمَّ ابْنُهُ عَلِيٌّ ثُمَّ ابْنُهُ الحسَنُ ثُمَّ الحجَّةُ ابْنُ الحسَنِ، فَهَذِهِ اثْنَا عَشَرَ أَئِمَّةً عَدَدِ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ»([48]).
2ـ وروى الكليني بسنده عن أبي هاشم داود بن قاسم الجعفري عن أبي جعفر الثاني (الإمام الجواد×) قال:
«أَقْبَلَ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ× وَمَعَهُ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ× وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى يَدِ سَلْمَانَ فَدَخَلَ المسْجِدَ الحرَامَ فَجَلَسَ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَسَنُ الهيْئَةِ وَاللِّبَاسِ فَسَلَّمَ عَلَى أَمِيرِ المؤْمِنِينَ، فَرَدَّ×فَجَلَسَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ إِنْ أَخْبَرْتَنِي بِهِنَّ عَلِمْتُ أَنَّ الْقَوْمَ رَكِبُوا مِنْ أَمْرِكَ مَا قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَأَنْ لَيْسُوا بِمَأْمُونِينَ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى عَلِمْتُ أَنَّكَ وَهُمْ شَرَعٌ سَوَاءٌ. فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ×: سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ، قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّجُلِ إِذَا نَامَ أَيْنَ تَذْهَبُ رُوحُهُ وَعَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يَذْكُرُ وَيَنْسَى؟ وَعَنِ الرَّجُلِ كَيْفَ يُشْبِهُ وَلَدُهُ الْأَعْمَامَ وَالْأَخْوَالَ؟ فَالْتَفَتَ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ× إِلَى الحسَنِ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَجِبْهُ، قَالَ: فَأَجَابَهُ الحسَنُ×. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِهَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ وَلَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِذَلِكَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّ رَسُولِ اللهِ| وَالْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ ـ وَأَشَارَ إِلَى أَمِيرِ المؤْمِنِينَ ـ وَلَمْ أَزَلْ أَشْهَدُ بِهَا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَصِيُّهُ وَالْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ ـ وَأَشَارَ إِلَى الحسَنِ× ـ وَأَشْهَدُ أَنَّ الحسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَصِيُّ أَخِيهِ وَالْقَائِمُ بِحُجَّتِهِ بَعْدَهُ وَأَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الحسَيْنِ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ الحسَيْنِ بَعْدَهُ وَأَشْهَدُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيِّ بْنِ الحسَيْنِ وَأَشْهَدُ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِأَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ وَأَشْهَدُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَأَشْهَدُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى وَأَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِأَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَشْهَدُ عَلَى الحسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بِأَنَّهُ الْقَائِمُ بِأَمْرِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَشْهَدُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ وُلْدِ الحسَنِ لَا يُكَنَّى وَلَا يُسَمَّى حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُهُ فَيَمْلَأَهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، ثُمَّ قَامَ فَمَضَى، فَقَالَ أَمِيرُ المؤْمِنِينَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اتْبَعْهُ فَانْظُرْ أَيْنَ يَقْصِدُ فَخَرَجَ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ× فَقَالَ: مَا كَانَ إِلَّا أَنْ وَضَعَ رِجْلَهُ خَارِجاً مِنَ المسْجِدِ فَمَا دَرَيْتُ أَيْنَ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ اللهِ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَمِيرِ المؤْمِنِينَ× فَأَعْلَمْتُهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَتَعْرِفُهُ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ وَأَمِيرُ المؤْمِنِينَ أَعْلَمُ، قَالَ: هُوَ الخضِرُ×»([49]).
3ـ وروى الكليني أيضاً بسنده عن أبي بصير عن الإمام الصادق× قال:
«قَالَ أَبِي لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَمَتَى يَخِفُّ عَلَيْكَ أَنْ أَخْلُوَ بِكَ فَأَسْأَلَكَ عَنْهَا؟ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ: أَيَّ الْأَوْقَاتِ أَحْبَبْتَهُ فَخَلَا بِهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَقَالَ لَهُ: يَا جَابِرُ أَخْبِرْنِي عَنِ اللَّوْحِ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي يَدِ أُمِّي فَاطِمَةَ‘ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ| وَمَا أَخْبَرَتْكَ بِهِ أُمِّي أَنَّهُ فِي ذَلِكَ اللَّوْحِ مَكْتُوبٌ؟ فَقَالَ جَابِرٌ: أَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُمِّكَ فَاطِمَةَ‘ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ| فَهَنَّيْتُهَا بِوِلَادَةِ الحسَيْنِ وَرَأَيْتُ فِي يَدَيْهَا لَوْحاً أَخْضَرَ، ظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ زُمُرُّدٍ وَرَأَيْتُ فِيهِ كِتَاباً أَبْيَضَ، شِبْهَ لَوْنِ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ لَهَا: بِأَبِي وَأُمِّي يَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ| مَا هَذَا اللَّوْحُ؟ فَقَالَتْ: هَذَا لَوْحٌ أَهْدَاهُ اللهُ إِلَى رَسُولِهِ| فِيهِ اسْمُ أَبِي وَاسْمُ بَعْلِي وَاسْمُ ابْنَيَّ وَاسْمُ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَأَعْطَانِيهِ أَبِي لِيُبَشِّرَنِي بِذَلِكَ، قَالَ جَابِرٌ: فَأَعْطَتْنِيهِ أُمُّكَ فَاطِمَةُ‘ فَقَرَأْتُهُ وَاسْتَنْسَخْتُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: فَهَلْ لَكَ يَا جَابِرُ أَنْ تَعْرِضَهُ عَلَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَشَى مَعَهُ أَبِي إِلَى مَنْزِلِ جَابِرٍ فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ رَقٍّ، فَقَالَ: يَا جَابِرُ انْظُرْ فِي كِتَابِكَ لِأَقْرَأَ [أَنَا] عَلَيْكَ، فَنَظَرَ جَابِرٌ فِي نُسْخَتِهِ فَقَرَأَهُ أَبِي فَمَا خَالَفَ حَرْفٌ حَرْفاً، فَقَالَ جَابِرٌ: فَأَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّي هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي اللَّوْحِ مَكْتُوباً:
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الحكِيمِ لِمُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ وَنُورِهِ وَسَفِيرِهِ وَحِجَابِهِ وَدَلِيلِهِ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، عَظِّمْ يَا مُحَمَّدُ أَسْمَائِي وَاشْكُرْ نَعْمَائِي وَلَا تَجْحَدْ آلَائِي، إِنِّي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا قَاصِمُ الجبَّارِينَ وَمُدِيلُ المظْلُومِينَ وَدَيَّانُ الدِّينِ، إِنِّي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا، فَمَنْ رَجَا غَيْرَ فَضْلِي أَوْ خَافَ غَيْرَ عَدْلِي، عَذَّبْتُهُ عَذاباً لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ فَإِيَّايَ فَاعْبُدْ وَعَلَيَّ فَتَوَكَّلْ، إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ نَبِيّاً فَأُكْمِلَتْ أَيَّامُهُ وَانْقَضَتْ مُدَّتُهُ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ وَصِيّاً وَإِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَفَضَّلْتُ وَصِيَّكَ عَلَى الْأَوْصِيَاءِ وَأَكْرَمْتُكَ بِشِبْلَيْكَ وَسِبْطَيْكَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَجَعَلْتُ حَسَناً مَعْدِنَ عِلْمِي بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ أَبِيهِ وَجَعَلْتُ حُسَيْناً خَازِنَ وَحْيِي وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ وَخَتَمْتُ لَهُ بِالسَّعَادَةِ، فَهُوَ أَفْضَلُ مَنِ اسْتُشْهِدَ وَأَرْفَعُ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةً، جَعَلْتُ كَلِمَتِيَ التَّامَّةَ مَعَهُ وَحُجَّتِيَ الْبَالِغَةَ عِنْدَهُ، بِعِتْرَتِهِ أُثِيبُ وَأُعَاقِبُ، أَوَّلُهُمْ عَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ وَزَيْنُ أَوْلِيَائِيَ الماضِينَ وَابْنُهُ شِبْهُ جَدِّهِ المحْمُودِ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ عِلْمِي وَالمعْدِنُ لِحِكْمَتِي سَيَهْلِكُ المرْتَابُونَ فِي جَعْفَرٍ، الرَّادُّ عَلَيْهِ كَالرَّادِّ عَلَيَّ، حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأُكْرِمَنَّ مَثْوَى جَعْفَرٍ وَلَأَسُرَّنَّهُ فِي أَشْيَاعِهِ وَأَنْصَارِهِ وَأَوْلِيَائِهِ، أُتِيحَتْ بَعْدَهُ مُوسَى فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ حِنْدِسٌ لِأَنَّ خَيْطَ فَرْضِي لَا يَنْقَطِعُ وَحُجَّتِي لَا تَخْفَى وَأَنَّ أَوْلِيَائِي يُسْقَوْنَ بِالْكَأْسِ الْأَوْفَى، مَنْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَقَدْ جَحَدَ نِعْمَتِي وَمَنْ غَيَّرَ آيَةً مِنْ كِتَابِي فَقَدِ افْتَرَى عَلَيَّ، وَيْلٌ لِلْمُفْتَرِينَ الجاحِدِينَ عِنْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ مُوسَى عَبْدِي وَحَبِيبِي وَخِيَرَتِي فِي عَلِيٍّ وَلِيِّي وَنَاصِرِي وَمَنْ أَضَعُ عَلَيْهِ أَعْبَاءَ النُّبُوَّةِ وَأَمْتَحِنُهُ بِالاضْطِلَاعِ بِهَا يَقْتُلُهُ عِفْرِيتٌ مُسْتَكْبِرٌ يُدْفَنُ فِي المدِينَةِ الَّتِي بَنَاهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ إِلَى جَنْبِ شَرِّ خَلْقِي حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَسُرَّنَّهُ بِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ وَخَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ، فَهُوَ مَعْدِنُ عِلْمِي وَمَوْضِعُ سِرِّي وَحُجَّتِي عَلَى خَلْقِي لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ بِهِ إِلَّا جَعَلْتُ الجنَّةَ مَثْوَاهُ وَشَفَّعْتُهُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ وَأَخْتِمُ بِالسَّعَادَةِ لِابْنِهِ عَلِيٍّ وَلِيِّي وَنَاصِرِي وَالشَّاهِدِ فِي خَلْقِي وَأَمِينِي عَلَى وَحْيِي، أُخْرِجُ مِنْهُ الدَّاعِيَ إِلَى سَبِيلِي وَالخازِنَ لِعِلْمِيَ الحسَنَ وَأُكْمِلُ ذَلِكَ بِابْنِهِ (محمد) رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عَلَيْهِ كَمَالُ مُوسَى وَبَهَاءُ عِيسَى وَصَبْرُ أَيُّوبَ فَيُذَلُّ أَوْلِيَائِي فِي زَمَانِهِ وَتُتَهَادَى رُؤوسُهُمْ كَمَا تُتَهَادَى رُؤوسُ التُّرْكِ وَالدَّيْلَمِ فَيُقْتَلُونَ وَيُحْرَقُونَ وَيَكُونُونَ خَائِفِينَ، مَرْعُوبِينَ، وَجِلِينَ، تُصْبَغُ الْأَرْضُ بِدِمَائِهِمْ وَيَفْشُو الْوَيْلُ وَالرَّنَّةُ فِي نِسَائِهِمْ أُولَئِكَ أَوْلِيَائِي حَقّاً، بِهِمْ أَدْفَعُ كُلَّ فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ حِنْدِسٍ وَبِهِمْ أَكْشِفُ الزَّلَازِلَ وَأَدْفَعُ الْآصَارَ وَالْأَغْلَالَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ المهْتَدُونَ»([50]).
4 ـ النصوص على إمامة الإمام الحسين×
صرّحت بعض الروايات بإمامة الإمام الحسين× على وجه الخصوص، نشير إلى بعضها فيما يلي:
1ـ قال الشيخ المفيد:
«وقد صرّح رسول الله| بالنصّ على إمامته وإمامة أخيه من قبله بقوله: ابْنَايَ هَذَانِ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا.
ودلت وصيّة الحسن× إليه على إمامته كما دلت وصية أمير المؤمنين إلى الحسن على إمامته بحسب ما دلت وصية رسول الله| إلى أمير المؤمنين على إمامته من بعده»([51]).
2ـ وروى الكليني بسنده عن سليم بن قيس أنّه قال:
«شَهِدْتُ وَصِيَّةَ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ× حِينَ أَوْصَى إِلَى
ابْنِهِ الحسَنِ× وَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ الحسَيْنَ× وَمُحَمَّداً وَجَمِيعَ
وُلْدِهِ وَرُؤَسَاءَ شِيعَتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ
الْكِتَابَ وَالسِّلَاحَ وَقَالَ لِابْنِهِ الحسَنِ×: يَا بُنَيَّ أَمَرَنِي
رَسُولُ اللهِ| أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ وَأَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي
وَسِلَاحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ| وَدَفَعَ إِلَيَّ كُتُبَهُ
وَسِلَاحَهُ، وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الموْتُ أَنْ تَدْفَعَهَا
إِلَى أَخِيكَ الحسَيْنِ×، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ابْنِهِ الحسَيْنِ× فَقَالَ:
وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ| أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى ابْنِكَ هَذَا، ثُمَّ أَخَذَ
بِيَدِ
عَلِيِّ بْنِ الحسَيْنِ×، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الحسَيْنِ: وَأَمَرَكَ
رَسُولُ اللهِ| أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَقْرِئْهُ
مِنْ رَسُولِ اللهِ| وَمِنِّي السَّلَامَ»([52]).
3ـ وروى الكليني أيضاً بسنده عن محمّد بن مسلم قال:
«سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ× يَقُولُ: لَمَّا حَضَرَ الحسَنَ بْنَ عَلِيٍّ÷ الْوَفَاةُ قَالَ لِلْحُسَيْنِ×: يَا أَخِي إِنِّي أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا، إِذَا أَنَا مِتُّ فَهَيِّئْنِي...»([53]).
4ـ وروى الكليني أيضاً بسنده عن المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق× قال:
«لَمَّا حَضَرَتِ الحسَنَ بْنَ عَلِيٍّ÷ الْوَفَاةُ، قَالَ: يَا قَنْبَرُ انْظُرْ هَلْ تَرَى مِنْ وَرَاءِ بَابِكَ مُؤْمِناً مِنْ غَيْرِ آلِ مُحَمَّدٍ|؟ فَقَالَ: اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ وَابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، قَالَ: ادْعُ لِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، فَأَتَيْتُهُ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: هَلْ حَدَثَ إِلَّا خَيْرٌ؟ قُلْتُ: أَجِبْ أَبَا مُحَمَّدٍ فَعَجَّلَ عَلَى شِسْعِ نَعْلِهِ، فَلَمْ يُسَوِّهِ وَخَرَجَ مَعِي يَعْدُو، فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ سَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ÷: اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلُكَ يَغِيبُ عَنْ سَمَاعِ كَلَامٍ يَحْيَى بِهِ الْأَمْوَاتُ، وَيَمُوتُ بِهِ الْأَحْيَاءُ...
يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الحسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ÷ بَعْدَ وَفَاةِ نَفْسِي، وَمُفَارَقَةِ رُوحِي جِسْمِي، إِمَامٌ مِنْ بَعْدِي، وَعِنْدَ اللهِ جَلَّ اسْمُهُ فِي الْكِتَابِ، وِرَاثَةً مِنَ النَّبِيِّ| أَضَافَهَا اللهُ} لَهُ فِي وِرَاثَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَعَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ خِيَرَةُ خَلْقِهِ، فَاصْطَفَى مِنْكُمْ مُحَمَّداً| وَاخْتَارَ مُحَمَّدٌ عَلِيّاً× وَاخْتَارَنِي عَلِيٌّ× بِالْإِمَامَةِ وَاخْتَرْتُ أَنَا
مرجعية الإمام الحسين× الدينية والعلمية
تُعدّ آية التطهير من الآيات الدالة على عصمة الإمام الحسين× وعلى مرجعيته الدينية، كما وتدلّ أيضاً على أنّ سيرته حجّة على العباد، قال تعالى:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([54]).
نبدأ بالإشارة إلى الروايات الواردة بشأن نزول الآية الكريمة:
«خَرَجَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الحسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)»([55]).
2ـ وروى الترمذي بسنده عن أم سلمة:
«أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جَلَّلَ عَلَى الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً»([56]).
3ـ كما روى أيضاً بسنده عن عمر بن أبي سلمة (ربيب النبي|):
«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ»([57]).
4ـ وروى أيضاً بسنده عن أنس بن مالك:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ يَقُولُ: الصَّلَاةَ يَا أَهْلَ البَيْتِ(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)»([58]).
5ـ وروى أحمد بن حنبل بسنده عن أم سلمة:
«أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِبُرْمَةٍ، فِيهَا خَزِيرَةٌ، فَدَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ. قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ، وَالحسَيْنُ، وَالحسَنُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الخزِيرَةِ، وَهُوَ عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّانٍ تَحْتَهُ كِسَاءٌ خَيْبَرِيٌّ. قَالَتْ: وَأَنَا أُصَلِّي فِي الحجْرَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ} هَذِهِ الْآيَةَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا). قَالَتْ: فَأَخَذَ فَضْلَ الْكِسَاءِ، فَغَشَّاهُمْ بِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ، فَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً، اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً. قَالَتْ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْبَيْتَ، فَقُلْتُ: وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ، إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ»([59])
آية (أهل الذكر) من الآيات التي يمكن تطبيقها على أهل بيت العصمة والطهارة بما فيهم سيّد الشهداء×، يقول سبحانه:
(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)([60]).
من المقصود بأهل الذكر؟ أهم علماء أهل الكتاب أم أهل بيت الرسول|؟ وكيف تدلّ هذه الآية على إمامة ومرجعيّة أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين×؟ سوف نطرح هذه الأسئلة في هذا الفصل ونبحثها بصورة مفصّلة تحت العناوين التالية:
مصداق أهل الذكر في روايات أهل البيت ^
عند الرجوع إلى روايات أهل البيت^ نكتشف أنّ المقصود بـ(أهل الذكر) والمصداق لهذا المصطلح القرآني هم أهل بيت الرسول| بما فيهم الإمام الحسين×؛ فعلى جميع المسلمين الرجوع إلى هذه السلالة الطاهرة في كل المسائل الدينية والدنيوية.
من الروايات الدالة على ما نحن فيه:
1ـ روى الكليني بسنده عن الإمام الصادق× حول(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) أنّه قال:
«الذِّكْرُ مُحَمَّدٌ| وَنَحْنُ أَهْلُهُ المسْؤولُونَ. قَالَ: قُلْتُ: قَوْلُهُ: (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ) ([61]).قَالَ: إِيَّانَا عَنَى وَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَنَحْنُ المسْؤولُونَ»([62]).
2ـ وروى أيضاً بسنده عن الوشاء:
«سَأَلْتُ الرِّضَا× فَقُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ). فَقَالَ: نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ وَنَحْنُ المسْؤولُونَ»([63]).
3ـ روى الشيخ الصدوق بسنده عن الريان بن الصلت عن الإمام الرضا× أنّه قال خلال حديث له:
«... فَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ:(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).فَقَالَتِ الْعُلَمَاءُ: إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ أَبُو الحسَنِ×: سُبْحَانَ اللهِ! وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ إِذاً يَدْعُونَّا إِلَى دِينِهِمْ، وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ المأْمُونُ: فَهَلْ عِنْدَكَ فِي ذَلِكَ شَرْحٌ بِخِلَافِ مَا قَالُوا، يَا أَبَا الحسَنِ؟ فَقَالَ×: نَعَمْ، الذِّكْرُ رَسُولُ اللهِ وَنَحْنُ أَهْلُهُ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللهِ} حَيْثُ يَقُولُ فِي سُورَةِ الطَّلَاقِ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ)([64])، فَالذِّكْرُ رَسُولُ اللهِ وَنَحْنُ أَهْلُهُ»([65]).
4ـ روى الكليني بسنده عن عبد الحميد بن أبي ديلم عن الإمام الصادق×، في بيان قوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) قال:
«الْكِتَابُ هُوَ الذِّكْرُ، وَأَهْلُهُ آلُ مُحَمَّدٍ|، أَمَرَ اللهُ بِسُؤَالِهِمْ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِسُؤَالِ الجهَّالِ، وَسَمَّى اللهُ الْقُرْآنَ ذِكْراً، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) وَقَالَ: (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)»([66]).
مصاديق (الذكر) في القرآن الكريم
استعملت كلمة (الذكر) في القرآن الكريم دلالة على مصاديق متعددة منها:
حيث قال الله تعالى:
(فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا * رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ)([67]).
يقول سبحانه:
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)([68]).
وقال أيضاً:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ([69]).
يبدو أنّ معنى الذكر واحد والاختلاف في المصاديق فحسب؛ لأنّ كلاً من القرآن والرسول| ممهّدان لذكر لله سبحانه، فهما شعائر تجذب الناس إلى الإقبال نحو الحقّ تعالى. بعبارة أخرى: إنّهما الكتاب الصامت والكتاب الناطق، وكلاهما مذكّر بالله. فلا فرق في أن يقرأ الإنسان القرآن أو ينظر إلى رسول الله| وسلوكه، إذ كلا الأمرين يوصلان، وكذا في أهل بيت النبوة^، بما أنّهم العدل للقرآن الكريم، فإنّهم مذكّرون بالله تعالى، وقد أشار رسول الرحمة| إلى هذا الأمر في حديثه المعروف بـ(الثقلين) بأنّهم عدل القرآن وأكّد أنّهما لن يفترقا أبداً. إذن تفسير الروايات للذكر بأنّه رسول الله| لا يتعارض مع تفسير روايات أُخر بأنّه القرآن، إذ كلا الأمرين واحد في المقام.
يبدو أنّ الخطاب في الآية الكريمة للرسول| وقومه، وقال بعضٌ: إنّه خطاب للمشركين أيضاً.
وأمّا كلمة (الذكر) فبمعنى حفظ مفهوم الشيء أو استحضاره في الذهن، وفي ذلك يقول الراغب الإصفهاني:
«الذِّكْرُ: تارة يقال ويراد به هيئة للنّفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ إلّا أنّ الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذِّكْرُ يقال اعتباراً باستحضاره، وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل: الذّكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللّسان. وكلّ واحد منهما ضربان: ذكر عن نسيان وذكر لا عن نسيان بل عن إدامة الحفظ»([70]).
ظاهراً أنّ الأصل في (الذكر) يستخدم في القلب والفؤاد وإن استعملت هذه الكلمة في اللفظ فباعتبار أنّ الإنسان يتوصل للمعنى من خلال اللفظ، ولذا استفاد القرآن من لفظ (الذكر) للكتب السماوية لا سيما القرآن، وبما أنّ أهل البيت^ أعلم بما في البيت، فلا بدّ لمن أراد الاطلاع على شيء الرجوع إلى أهله.
توجد أقوال مختلفة في المراد من (أهل الذكر) في هذه الآية:
1ـ قال بعضهم: المراد من (أهل الذكر) من لديه اطلاع بأخبار الأمم الماضية كافرة كانت أم مؤمنة.
لكن هذا الاحتمال مجاز وخلاف الظاهر؛ لأنّ استعمال كلمة «الذكر» في (العلم) على خلاف ظاهر اللفظ، وهذا الانصراف في المعنى يحتاج إلى قرينةٍ قطعية وهي غير حاصلة في الآية، خاصة وأنّ القرآن الكريم لم يستخدم هذه الكلمة بهذا المعنى.
2ـ الاحتمال الثاني: إنّ المقصود من (أهل الذكر) في الآية خصوص أهل البيت^، وعلى رأسهم الإمام علي بن أبي طالب×؛ لأنّه× معروف بالصدق والوثوق بين الصحابة، وله مكانة مرموقة وقدسيّة خاصة بين عامة الناس وخاصّتهم ـ حتّى المشركين منهم ـ وذلك لولادته في الكعبة المشرّفة.
3ـ يرى بعضهم أنّ المقصود من (أهل الذكر) هم أهل القرآن.
وهذا الاحتمال لا يبدو صحيحاً؛ لأنّه لا يتناسب مع الاحتجاج الوارد في الآية، وذلك لأنّ المخالفين والمشركين لم يقبلوا نبوة النبي| فكيف لهم أن يقبلوها ويصدّقوا بها إن دعاهم لها أتباع النبي والمؤمنون به.
4ـ الرأي الآخر جمع بين تنزيل الآية وتطبيقها في كل زمان ومكان، وقال بأنّ الآية تشير إلى أصل عقلائي عام وهو وجوب الرجوع إلى أهل العلم والخبر، على الرغم من أنّ تنزيلها هو الأمر بالرجوع إلى مطلق أصحاب الكتب السماوية. بعبارة أخرى: إنّ نزول الآية كان لأمر الكفار والمشركين والمخالفين للرسول| بالرجوع إلى أصحاب الكتب السماوية، لكن الآية لها تطبيق في كل زمان ومكان، لذا قيل: إنّ شأن نزول الآية وموردها لا يخصص أصل الوارد وحكمه. إذن، إنّ كلّ شخص جاهل بالمعارف الإلهية، في أيّ عصرٍ وزمان، يجب عليه الرجوع إلى أهل الذكر، ومصداقهم في هذا العصر أهل بيت النبي الأكرم|.
والشاهد على هذا المعنى، الرواية التي يرويها الطبراني بسنده عن جابر عن رسول الله|:
«لَا يَنْبَغِي لِلْعَالَمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ، قَالَ اللهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)»([71]).
من خلال التأمّل في آيات القرآن الكريم والجمع بينها وبين آيات أُخر، وكذا بالاستعانة بالروايات، يتبيّن لنا أنّ أهل البيت^ هم الحملة الحقيقيّون للقرآن وحقائقه، يقول تعالى:
(إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) ([72]).
تشير هذه الآية إلى مقدّمة كليّة كبرى لقياسٍ منطقي يمكننا من خلاله إثبات كون أهل البيت^ هم حملة القرآن وحقائقه، وهي أنّ حقيقة القرآن وروحه لا يصل إليها إلّا المنزّهون عن كلّ العيوب والنقائص والذنوب.
كما تشير آية التطهير إلى صغرى القياس وهي مصداق أولئك الطاهرون الذين ارتقوا إلى روح القرآن وبلغوا إلى حقائقه الإلهية، حيث يقول تعالى:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) ([73]).
وعند ملاحظة الأحاديث النبوية نصل إلى أنّ المراد من أهل البيت في الآية الكريمة هم أصحاب الكساء الخمسة، على الرغم من أنّ الحصر في الآية الكريمة كان حصراً إضافياً، أي أنّه أخرج نساء النبي| وأصحابه، فلا مانع إذن من شمول الآية لسائر الأئمة المعصومين^.
روى مسلم بسنده عن عائشة:
«خَرَجَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الحسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)»([74]).
(أهل الذكر) في أحاديث أهل السنّة
روى الحاكم الحسكاني بسنده عن الحارث قال:
«سَأَلْتُ عَلِيّاً عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ) فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّا لَنَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ، نَحْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَنَحْنُ مَعْدِنُ التَّأْوِيلِ وَالتَّنْزِيلِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ} يَقُولُ: أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْعِلْمَ فَلْيَأْتِهِ مِنْ بَابِهِ»([75]).
الإمام الحسين× أحد مصاديق أهل الذكر الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم والسؤال منهم، فعلينا أن نرجع إليه ونسأله وإنّنا لمسؤولون عن ذلك.
قال تعالى:
(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)([76]).
من الآيات التي يستدل بها على فضائل أهل البيت^ آية (علم الكتاب) حيث بضمّ الشواهد والقرائن من الآيات والروايات إلى هذه الآية المباركة يمكننا إثبات فضيلة عظيمة لتلك العترة الطاهرة بما فيهم الإمام الحسين×، ألا وهي المرجعية الدينية والإمامة، وذلك بدراسة الآية الكريمة التي تشير إلى عدّة نقاط جديرة بالتأمّل، منها ما يلي:
1ـ (عِنْدَهُ) ظرف وخبر لـ(عِلْم الْكِتَابِ) وللخبر حقّ التأخير عن المبتدأ، لكنّه قدّم هنا، وطبقاً لقاعدة «تقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصر» نقول: إنّ علم الكتاب بأكمله لا يوجد إلّا عند بعض الأشخاص فحسب.
2ـ إنّ شهادة من عندهم علم الكتاب لم تكن لأجل تكميل شهادة الله}؛ لأنّ شهادته سبحانه تامّة لا تحتاج إلى ضمّ شهادة إليها، بل إنّ كل شهادة تُعتبر دليلاً تاماً على إثبات النبوة والرسالة، كما أنّ ما ورد في الآية لم يكن من قبيل ضمّ الدليل الظني إلى الدليل العلمي، بل من قبيل التمسك بدليلين قطعيين معتمدين يورثان اليقين، أحدهما شهادة الله تعالى والآخر شهادة من عندهم علم الكتاب، والتعدد يقتضي المغايرة عادةً.
3ـ الظاهر أنّ (الألف واللام) في (عِلْمُ الْكِتَابِ) للعهد وتعود إلى القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء، أو أنّها تعود إلى اللوح المحفوظ الذي كُتب فيه كلّ شيء وما القرآن إلّا تنزيل لذلك اللوح.
4ـ إنّ شهادة الله ليست كشهادة الإنسان، فشهادته تعالى على رسالة النبي فعليةٌ لا لفظية من قبيل إيجاد الكلام والحديث في الخارج، بل إنّ شهادته تعالى تتمّ بإظهار المعجزات على يد النبي تصديقاً لدعواه، وهو عمل إلهيٌ خارق للعادة؛ أمّا شهادة من عندهم علم الكتاب فهي على نحوين: أحدهما قولي يتمّ بإقرار اللسان، والآخر فعليّ بالاتباع والامتثال للتشريعات الإلهية.
5ـ ليس المقصود من (عِلْمُ الْكِتَابِ) العلم بظواهر القرآن فحسب؛ لأنّ هكذا علم ينسجم أيضاً مع عدم العصمة واتّباع الهوى وبالتالي ستكون شهادة أصحابه غير مفيدة للعلم واليقين، بل المراد بعلم الكتاب العلم بظاهره وباطنه، وتنزيله وخفاياه والأسرار المودعة فيه، وهي أمور موهوبة من قبل الله تعالى غير مكتسبة من واسطة معيّنة، لذا لا يمكن الحصول عليها إلّا إذا كان الفرد معصوماً مطهّراً من الذنوب والخطايا العمدية والسهوية، حينها تكون شهادته مفيدة للعلم ومقبولة عند العقل، ولذا فهي مضاهية لشهادة الله.
6ـ من الأمور المطروحة في علم الأصول عند البعض أنّ المصدر المضاف كـ(علم) يفيد العموم الاستغراقي، خاصةً إذا كان المصدر مضافاً إلى مفردٍ محلّى بالألف واللام كـ(الكتاب).
7ـ إنّ سورة الرعد مكية، وقد صرّح بذلك النيسابوري عن سعيد بن جبير([77]) والبغوي في (معالم التنزيل)([78]).والشاهد على ذلك أنّ آياتها تحتجّ بالتوحيد والرسالة والنبي على المشركين الذين ينكرون آيات الله ويسخرون بنبيّه الأكرم|.
8 ـ من خلال التأمّل في النقاط المذكورة أعلاه يتّضح أنّ المراد من (عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) ليس عبد الله بن سلام وأمثاله من أهل الكتاب؛ وذلك لعدّة أسباب:
أوّلاً: أشرنا إلى أنّ (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) يجب أن تكون شهادتهم مضاهية لشهادة الله، وأن تكون مفيدة للعلم واليقين ولا يحصل ذلك للفرد إلّا بعد ثبوت العصمة والطهارة له، وأن يكون عالماً بظاهر القرآن وباطنه، ونحن نعلم أنّ عبد الله بن سلام ونظائره من علماء اليهود لم يصلوا إلى هذا المقام أبداً وإلّا لما بقوا على شريعة موسى×؛ لأنّ بقاءهم على تلك الشريعة إمّا عناداً للحقّ أو جهلاً وكلا الأمرين يتنافيان مع مقام العصمة.
ثانياً: إضافة (علم) لـ(الكتاب) تفيد الاستغراق والعموم، أي العلم بكل القرآن، وإن كان مراده العلم ببعض القرآن لجاء بـ(من) التبعيضية، مثلما ورد في آصف بن برخيا حيث قال تعالى:
(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ)([79]).
إضافة إلى أنّ العلم بكل الكتاب لم يكن عند عموم الأنبياء^ فضلاً عن علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
ثالثاً: إنّ آيات سورة الرعد مكيّة بأجمعها، في حين أنّ عبد الله بن سلام وسائر علماء أهل الكتاب كانوا يقطنون المدينة وكان إسلامهم بعد هجرة النبي|؛ لذا يقول سعيد بن جبير:
«كيف تكون هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام والسورة كلّها مكية»([80]).
والحاصل، لا يمكن أن تكون هذه الآية في عبد الله بن سلام وأهل الكتاب، بل المقصود منها أهل بيت النبي| وعلى رأسهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب÷، وأمّا حصر شأن نزول الآية في بعض الروايات بالإمام علي× لإخراج أمثال عبد الله بن سلام. بعبارة أخرى: الحصر في الرواية حصر إضافي لا حقيقي.
إمامة الإمام الحسين× ومرجعيّته الدينية
يمكننا إثبات الإمامة والمرجعية الدينية لأهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين× من خلال بيان بعض المقدّمات وضمّها إلى آية (علم الكتاب):
قال الله تعالى في القرآن الكريم:
(إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)([81]).
هناك احتمالان في (لَا يَمَسُّهُ)؛ الأوّل: هو المس الظاهري بأعضاء البدن، والآخر: هو المسّ الباطني. كما كلا الاحتمالين في (الْمُطَهَّرُونَ)؛ أحدهما: الطهارة الظاهرية بأعضاء البدن، والآخر: الطهارة الباطنية بالقلب.
يبيّن لنا القرآن الكريم من هم المطهّرون وذلك في قوله تعالى:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([82]).
تحدّد الآية الشريفة مصداق المطهّرين، وهم أهل بيت النبي| لا غير.
ولأجل تعيين مصداق أهل البيت^ لا بدّ من الرجوع إلى الروايات؛ لأنّ الله تعالى قال في كتابه:
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)([83]).
بالرجوع إلى روايات الفريقين من الشيعة والسنّة ندرك أنّ المقصود من أهل البيت في آية التطهير، رسول الله|، علي، فاطمة، الحسن والحسين^. على الرغم من أنّ الحصر في الآية إضافي؛ وذلك لأجل إخراج أزواج النبي| وباقي الصحابة من شمول الآية، والنتيجة أنّ آية التطهير شاملة لبقية الأئمة الاثني عشر من أهل البيت^ أيضاً.
نخرج من هذه المقدّمات بنتيجةٍ مفادها أنّ أهل بيت العصمة والطهارة هم الأئمة والمرجع الديني للأمّة وأنّ تفسيرهم لآيات الكتاب حجّة على الناس جميعاً.
المقصود بـ(من عنده علم الكتاب)
بغضّ النظر عن ظهور الآية في المعصومين^، عندما نرجع إلى الروايات التفسيرية نجدها تبيّن أنّ المقصود من قوله تعالى: (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ) هم أهل البيت^ وعلى رأسهم علي بن أبي طالب×.
ومن روايات الشيعة والسنّة الواردة بهذا الصدد:
روى الكليني بسندٍ صحيح عن بريد بن معاوية قال:
«قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ×: (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ). قَالَ: إِيَّانَا عَنَى وَعَلِيٌّ أَوَّلُنَا وَأَفْضَلُنَا وَخَيْرُنَا بَعْدَ النَّبِيِّ»([84]).
وروى الحاكم الحسكاني بسنده عن أبي سعيد الخدري قوله:
«سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ| عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ).قَالَ: ذَاكَ أَخِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»([85]).
من الآيات الدّالة على عصمة أهل البيت^ ومرجعيتهم الدينية وولايتهم بما فيهم الإمام الحسين×، هي آية الاعتصام حيث يقول تعالى:
(وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)([86]).
قال الفيومي:
«عصمه الله من المكروه (يعصمه) من باب ضرب: حفظه ووقاه، و(اعتصمت) بالله: امتنعت به»([87]).
قال ابن فارس:
«واعتصم العبد بالله تعالى: إذا امتنع»([88]).
ومعنى الاعتصام بالله تعالى أو بحبله هو أن يحفظ الإنسان نفسه من البلايا والأعداء بواسطة اللجوء إلى الله والتمسّك بحبله ليصون نفسه من عقوبات الدنياوالآخرة.
يقول تعالى في سورة آل عمران:
(وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)([89]).
يأمرنا تعالى في الآية الكريمة إلى التمسّك والاعتصام بالحبل الإلهي، وبضمّ هذه الآية إلى الآية السابقة ندرك أنّ هناك سنخية بين الحق تعالى وبين حبله حتّى عدّ الاعتصام بحبله كالاعتصام به سبحانه، ولا يمكن أن يمثّل ذلك الحبل سوى المعصوم×.
بعد ملاحظة الآيات والروايات المعتبرة نصل إلى معرفة من يجب علينا الاعتصام والتمسّك بهم، وهم:
نقرأ في القرآن الكريم:
(وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)([90]).
ويقول أيضاً:
(إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ)([91]).
وقال كذلك:
(فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ)([92]).
يقول الله}:
(مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)([93]).
ويقول أيضاً:
(وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)([94]).
روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله| قال:
«وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي، كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّ اللَّطِيفَ الخبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحوْضَ...»([95]).
وفقاً للنصّ القرآني أنّ القرآن نفسه يتمتّع بمقام العصمة أيضاً، وأنّه مصون حين نزوله بواسطة جبرئيل على النبي|، وحين إبلاغه للناس، فلا يتخلله المشوبة والخطأ، بل يمكن القطع والقول يقيناً: إنّه كلام الله تعالى، ولذا يقول جلّ وعلا: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)([96]).
ومن الذين يجب اتّباعهم والاعتصام بهم أهل البيت^؛ لأنّ التمسّك والاعتصام بهم في طول التمسّك والاعتصام بالله تعالى وأنّ اتّباعهم اتّباع للحق والحقيقة.
ويمكن إثبات ذلك من خلال عدّة طرق:
أ) حديث الثقلين
يأمرنا حديث الثقلين ـ على الرغم من اختلاف بعض ألفاظه ـ بالتمسّك بكتاب الله وأهل البيت^ واتّباعهما، والتمسّك هنا بمعنى الاعتصام. إذن، فالاعتصام بـ(حبل الله) في الحقيقة هو التمسّك بكتاب الله وعترة رسوله|، الذين هم امتداد لرسالة النبي| والمبيّنين لسنّته، لذا نشاهد تعبير (الاعتصام) في بعض مضامين حديث الثقلين، من قبيل:
روى جابر عن النبي الأكرم| قال:
«تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي»([97]).
ب) أدلّة العصمة
أثبت القرآن الكريم والسنّة الشريفة مقام العصمة لأهل البيت^، وذلك بأدلّة عديدة كآية التطهير التي تمّ البحث فيها بصورةٍ مفصّلة.
قال تعالى:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([98]).
ج) التمسّك بحبل العترة
نقل الطبرسي عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله| قال:
«أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ حَبْلَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدِهِمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ كِتَابُ اللهِ حَبَلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي أَلَا وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحوْضَ»([99]).
(حبل اللّه) في روايات أهل البيت^
عند ملاحظة الروايات نجد أنّ أهل البيت^ يصرّحون بأنّهم المصداق لـ(حبل الله):
1ـ روى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الصادق× في تفسير قول الله سبحانه: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا) أنّه قال:
«نَحْنُ الحبْلُ»([100]).
2ـ روى عن جابر أنّ الإمام الباقر× قال:
«آلُ مُحَمَّدٍ| هُمْ حَبْلُ اللهِ الَّذِي أُمِرْنَا بِالاعْتِصَامِ بِهِ، فَقَالَ: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)»([101]).
(حبل اللّه) في روايات أهل السنّة
روى الثعلبي في تفسيره عن الإمام الصادق× قوله:
«نَحْنُ حَبْلُ اللهِ الَّذِي قَالَ اللهُ: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)»([102]).
بضمّ بعض الآيات القرآنية إلى بعضٍ ندرك أنّ أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين× قد مسّوا حقيقة القرآن ولهم علم تامّ بها، لذا فإنّ أقوالهم وبياناتهم في شرح وتفسير القرآن حجّة على الجميع، ويمكننا إثبات ذلك من خلال الاستدلال التالي:
يقول سبحانه:
(إِنَّهُ لَقُرْآَنٌ كَرِيمٌ* فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)([103])
هناك احتمالان في جملة (لَا يَمَسُّهُ)
1ـ عُقدت الجملةُ لإفادة النهي، بمعنى: لا يمسّ القرآن إلّا المطهرون.
2ـ عُقدت الجملةُ لإفادة النفي، بمعنى: لا يدرك حقيقة القرآن إلّا أصحاب النفوس الطاهرة.
وقد استخدمت كلمة (مسّ) في القرآن الكريم بكلا المعنيين، أي المسّ الظاهري والباطني، كما استخدمت الطهارة بكلا المعنيين أيضاً، أي الطهارة الظاهرية والباطنية.
قال تعالى:
(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)([104]).
يقول سبحانه:
(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ)([105]).
يقول الله:
(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)([106]).
يقول سبحانه:
(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ)([107]).
يُستفاد من بعض الآيات أنّ أهل البيت^ هم المصداق الحقيقي لـ(المطهّرون) كما في قوله تعالى:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([108]).
أنّ أحاديث أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين× المروية عنهم في ذيل آيات القرآن حجّة علينا.
يقول تعالى:
(بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ)([109]).
هناك احتمالان في المراد من (العلم):
نصل إلى هذا القول من خلال ضمّ بعض الآيات إلى بعضها من قبيل:
1ـ قال تعالى:
(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)([110]).
2ـ كما يقول أيضاً:
(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)([111]).
3ـ ويقول كذلك:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([112]).
فتكون النتيجة: أنّ آيات القرآن البيّنات في صدور أهل بيت العصمة والطهارة^.
مع هذا الاحتمال أيضاً يمكن الوصول إلى نتيجة بعد ضمّ بعض الآيات القرآنية:
كما يمكن إثبات هذا الاحتمال من خلال ضمّ بعض الآيات من قبيل:
1ـ آية عصمة الإمام.
قال تعالى:
(لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)([113]).
ويقول أيضاً:
(...وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)([114]).
2ـ منشأ العصمة هو العلم بحقائق الأمور.
يقول الله تعالى:
(قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ)([115]).
إنّ حقيقة القرآن مستقرة في صدور أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين×، وما كانت حقيقة القرآن في صدره فإنّ تفسيره للقرآن حجّة على الناس أجمع.
تدّل هذه الآية على المرجعية الدينية للإمام الحسين× لكن من خلال ضمّ بعض الآية إليها:
أ) يقول تعالى:
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا)([116]).
ب) ويقول أيضاً:
(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)([117]).
ج) وقال:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([118]).
أنّ أهل بيت العصمة والطهارة ومن جملتهم الإمام الحسين× هم ورثة كتاب الله، لذا فإنّ تفسيرهم لآيات الله وما ورد في ذيلها حجّة علينا.
ورد حديث الثقلين بمضامين مختلفة في أصحّ الكتب الحديثية لأهل السنّة، نذكر بعضها فيما يلي:
1ـ روى مسلم بسنده عن زيد بن أرقم:
«قَامَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْماً فِينَا خَطِيباً بِمَاءٍ يُدْعَى خُمّاً بَيْنَ مَكَّةَ وَالمدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيهِ الهدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ) فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي)»([119]).
2ـ وروى أحمد بن حنبل بسنده عن زيد بن ثابت أنّ رسول الله| قال:
«إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابُ اللهِ، حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الحوْضَ»([120]).
3ـ وروى الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله قوله:
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي»([121]).
4ـ وروى الحاكم النيسابوري بسنده عن ابن واثلة عن زيد بن أرقم:
«نَزَلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَيْنَ مَكَّةَ وَالمدِينَةِ عِنْدَ شَجَرَاتٍ خَمْسِ دَوْحَاتٍ عِظَامٍ، فَكَنَسَ النَّاسُ مَا تَحْتَ الشَّجَرَاتِ، ثُمَّ رَاحَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَشِيَّةً فَصَلَّى، ثُمَّ قَامَ خَطِيباً، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ وَوَعَظَ، فَقَالَ: مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا إِنِ اتَّبَعْتُمُوهُمَا، وَهُمَا: كِتَابُ اللهِ، وَأَهْلُ بَيْتِي عِتْرَتِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالمؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ»([122]).
الإمام الحسين× من عترة النبي| وأهل بيته الطاهرين، وقد أوصانا الرسول| باتّباعه، فهو كباقي الأئمة المعصومين الذين ثبتت مرجعيتهم الدينية للأمة، لذا فإنّ سنّته كالسنّة النبوية حجّة علينا.
روى عدد كبير من أهل السنّة (حديث السفينة) عن رسول الله|:
1ـ روى الحاكم النيسابوري بسنده عن حنش الكناني قوله:
«سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَنِي فَأَنَا مَنْ عَرَفْتُمْ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَأَنَا أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ»([123]).
2ـروى الطبراني بسنده أيضاً عن حنش بن المعتمر عن أبي ذر قال:
«سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) يَقُولُ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ، وَمِثْلِ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ»([124]).
3ـ ابن الأثير الجزري في مادة (زخخ) نقل هذا الحديث عن النبي| بهذا النحو:
«مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا زُخَّ بِهِ فِي النَّارِ»([125]).
الإمام الحسين× من أهل بيت النبي| وعترته الذين أوصى النبي| باتّباعهم، ومن أوصى النبي باتّباعه لا بدّ وأن يكون سبيلاً للنجاة والفلاح، لذا يمكننا من خلال هذا الحديث إثبات حجيّة سنّة الإمام الحسين×.
1ـ روى الحاكم النيسابوري بسند صحيح عن ابن عباس أنّ رسول الله| قال:
«النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ»([126]).
2ـ كما ورد عن رسول الله|:
«النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الِاخْتِلَافِ ـ أي المؤدّي لاستئصال الأمة ـ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ»([127]).
3ـ وروى أحمد بن حنبل بسنده عن رسول الله|:
«النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ السَّمَاءِ، إِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ»([128]).
كما روي هذا الحديث بمضامين أخرى لكنها قريبة المعنى.
إذا كان أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين× هم الأمان للأمّة من الاختلاف، إذن فهم المرجع الديني للأمّة وأنّ سنّتهم حجّة على الجميع.
11 ـ سنّة الإمام الحسين× طريق إلى السنّة النبوية
نخوض هذا البحث ببيان بعض المقدّمات:
المقدّمة الأولى: مصادر التشريع والاستنباط
لعل السؤال الأهم ـ بعد الإيمان بالله ورسوله ويوم القيامة ـ هو: ما المصدر الذي يجب اعتماده في تحصيل دين الله سبحانه؛ بأصوله وفروعه؟
إنّ الله تعالى فرض على عباده الطاعة لأوامره، ووضع أحكاماً وقوانين تضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة، لكن هذه القوانين تتطلب منبعاً معتبراً وأميناً كي يكون سنداً لها، وعليه يجب أن تكون منابع الاستنباط والتشريع من المسائل المهمّة جدّاً، حيث لا تجد ديناً أو مذهباً لم يولها اهتماماً بالغاً، وما يؤكّد ذلك أنّ الاختلاف الأساس بين المذاهب والآراء الفقهية والعقائدية يعود إلى الاختلاف في المصادر والمراجع التي يعتمدها العلماء في معرفة دين الله سبحانه، لذا كان البحث في منابع ومصادر التشريع ذا مكانةٍ خاصة دائماً.
المقدّمة الثانية: الكتاب والسنّة النبوية مصدران للتشريع
يمُثّل القرآن الكريم والسنّة النبوية، بل وكل الكتب السماوية وسنن الأنبياء^، منبعين مهمّين وأساسيين للتشريع والاستنباط ومعرفة الدين والأحكام الإلهية.
المصدر الأوّل للأحكام الإلهية عند المسلمين جميعاً هو القرآن الكريم، ثمّ السنّة النبوية بما فيها من قول وفعلٍ وتقرير، فهي السبيل الدالّة على حقيقة القرآن، وهي المصدر الذي يتكفّل بشرح وتفصيل المجمل والمتشابه في القرآن الكريم، بل وكلّ الأمور التي ذُكرت في الكتاب بصورةٍ كلية.
المقدّمة الثالثة: الموانع في طريق السنّة النبوية
للسنّة النبوية مكانتها الخاصة في الاستنباط والتشريع ولكن تحصيلها ليس بالأمر السهل، إذ تحفّ طريقه العديد من التحديات وتسدّه الكثير من الموانع، ولعلّه من الممكن القول بأنّ هذه من أهم المشاكل والبلايا التي مني بها المسلمون، بل والثقافة الإسلامية بصورة عامة؛ ذلك أنّ الطريق لحديث النبي| لو كان سهلاً ميسراَ للمسلمين لما وقعت كل هذه الاختلافات في فروع الدين وأصوله، ولما برزت هكذا انحرافات في التاريخ والثقافة الإسلامية الغنية. نشير هنا إلى بعض تلك المشكلات التي منيت بها السنّة النبوية:
1 ـ عدم اهتمام الصحابة بتدوين الحديث
عندما نرجع إلى التاريخ يتّضح لنا أنّ الصحابة لم يعيروا ثمّة اهتمام بالسؤال من النبي| ولم يقيّدوا حديثه، وهذا يعود إلى عدّة عوامل:
أ) العامل السياسي
كانت قريش تخطط لما بعد النبي|، لذا قامت منذ البداية بمنع كتابة حديث النبي| ونشر سنّته قدر ما استطاعت، وفي ذلك يقول عبد الله بن عمرو:
«كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟! فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ»([129]).
ب) الانشغال بأمور المعاش
كانت الحياة في المدينة صعبة جدّاً حيث كان العمل والكدّ يستغرق كل أوقات الناس متحمّلين المشاق في سبيل تأمين نفقاتهم اليومية؛ لذا استطاع عدّة من الناس فقط ـ ممن كان عملهم قليلاً ـ قضاء كلّ أوقاتهم أو جلّها برفقة النبي|، ليغترفوا من نميره العذب، بيد أنّ غيرهم إمّا لم يكن على علم بأحاديث النبي| أو اقتصر على الانتفاع غير المباشر بها عبر من تشرّفوا بلقائه|.
ج) عدم سؤال النبي|
لم يعتد الصحابة على السؤال من النبي| في أمور دينهم، بل كان بعضهم يترقب حضور إعرابي أو بدويّ يسأل النبي’ كي يستفيدوا من جواب النبي| له.
وفي ذلك قال أنس بن مالك:
«كُنَّا قَدْ نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ شَيْءٍ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ، فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ»([130]).
د) عدم وجود النظرة المستقبلية
لم يهتمّ الصحابة بالسؤال من النبي| وحفظ حديثه؛ لأنّ أغلبهم ما كان يظنّ أنّ الإسلام سيفتح الكثير من البلدان بعد رحيل النبي| فيحتاج المسلمون إلى حديثه وسنّته كثيراً.
وتضاعفت المشكلة بعد رحيل النبي| حينما أصدر كبار مدرسة الخلفاء وعلى رأسهم أبو بكر وعمر منع تدوين الحديث ونشره، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بحرق ذلك النزر القليل من الأحاديث التي كانت مدونة عند الصحابة.
1ـ قال ابن عباس:
«لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَجَعُهُ قَالَ: ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَاباً لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ، قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) غَلَبَهُ الْوَجَعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا، فَاخْتَلَفُوا، وَكَثُرَ اللَّغَطُ، قَالَ: (قُومُوا عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّنَازُعُ)»([131]).
2ـ ونقل شمس الدين الذهبي:
«إنّ الصدّيق جمع الناس بعد وفاة نبيهم فقال: إنّكم تحدّثون عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافاً فلا تحدّثوا عن رسول الله شيئاً، فمن سألكم فقولوا: بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه»([132]).
3ـ ومثله عن عائشة:
«جمع أبي الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكانت خمسمائة حديث فبات ليلته يتقلب كثيراً. قالت: فغمّني فقلت: أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغك؟ فلما أصبح قال: أي بنيّة هلمّي الأحاديث التي عندك فجئته بها فدعا بنار فحرقها»([133]).
4ـ وقد استمرّ عمر بن الخطاب على تلك السياسة الخطيرة، حيث ينقل ابن سعد:
«إنّ الأحاديث كثرت على عهد عمر بن الخطاب فأنشد الناس أن يأتوه بها فلما أتوه بها أمر بتحريقها»([134]).
وكان عمر يأمر عمّاله وولاته في المدن والبلدان أن لا يبثّوا حديث النبي وأن يحولوا دون انتشاره.
5ـ يقول قرظة بن كعب:
«لما سيّرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال: أتدرون لم شيّعتكم؟ قالوا: نعم تكرمة لنا. قال: ومع ذلك إنّكم تأتون أهل قرية لهم دويّ بالقرآن كدويّ النحل فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جرّدوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله وأنا شريككم»([135]).
بل وهدّد بنفي من يقوم بتدوين حديث النبي ونشره أمثال أبي هريرة([136])، بل وقام بزّج بعضهم في السجون([137]).
وقد اُعتمدت هذه السياسة أيام خلافة عثمان ومعاوية أيضاً. لذا أصدروا أمراً بعدم نقل أيّ حديث غير ما رُوي في عهد أبي بكر وعمر([138]).
لهذا السبب ولأسباب أخرى عانى المسلمون بعد رحيل النبي| من قلّة مصادر التشريع والاستنباط، وهذا ما دعا المسلمين نحو اللجوء إلى العمل بالرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان وغيرها من القواعد، ممّا أدّى إلى حرمان الأمّة مما يترتب على تلك الأحكام الواقعية من مصالح حقيقية ونتائج طبيعية. ولم يكن ذلك بالأمر القسري الصادر من الله تعالى، بل هو أمر أوجدته مدرسة الخلفاء وورّطت أتباعها في دوامته.
المقدّمة الرابعة: ضرورة الطريق إلى السنّة الحقيقية
وهنا سؤال يطرح نفسه: هل من الممكن أن يترك الله تعالى عباده بعد وفاة رسوله دون أن يضع لهم هادياً يرشدهم نحو الأحكام الواقعية؟ هل يليق برحمانية الله ولطفه أن يترك عباده بعد رسوله بين الشكّ والترديد ولم يدلّهم على سبيل معين يوصلهم إلى زلال المعارف النبوية؟ ألم يجعل سبحانه للناس بعد القرآن والسنّة النبوية سبيلاً يهديهم إلى حقيقة القرآن وسنّة الرسول؟ أم كان مقرراً أن يُحرم الناس بعد رحيل النبي| من سنّته الشريفة وليس أمامهم ثمّة سبيل للوصل إليها إلّا عن طريق الصحابة وحينها ستصل إلى الناس بصورة ظنية؛ لأنّنا نعلم أنّ الصحابة ليسوا معصومين كي يبيّنوا لنا سنّة رسول الله| دون خطأ وشائبة.
كان النبي| يتصدّى للإجابة عن تساؤلات المجتمع في مجال العقائد والفقه والمسائل الأخلاقية في عين توليه القيادة السياسية للأمة آنذاك وهو على يقين أنّ حاجة المجتمع هذه ليست حاجة مرحلية وإنّما هي مستمرة ودائمة، لذا مما هو مسلّم به أنّ المسلمين بحاجة إلى مرجع موثوق ومعتمد يستطيع أن يجيبهم في شتّى الأبعاد الدينية ويهديهم إلى الحقّ، لذا قام| منذ بداية دعوته بتربية أفرادٍ مؤهّلين للقيام بهذه المهمّة من بعده كي يسدّوا الخلأ من بعد رحيله. وعندما نرجع إلى التاريخ والأحاديث لم نجد أفراداً أعدّهم الرسول| للمرجعية الدينية غير علي بن أبي طالب× والأئمة الأحد عشر من ذريته بما فيهم الإمام الحسين×.
12 ـ ضرورة حفظ سنّة النبي’ بواسطة المعصوم×
نبيّن هذا الموضوع من خلال بعض المقدّمات:
المقدّمة الأولى: ضرورة الارتباط باللّه
الإنسان عصارة الخلقة، وكماله بالوصول إلى اللقاء الإلهي، ولا يتحقق الوصال بذلك المقصد الأعلى إلّا بالعمل بالشريعة والالتفات إلى باطنها.
المقدّمة الثانية: الغاية من التشريع
لعل هناك من يظن أنّ الغاية المنشودة من وراء التشريع هي بيان الحلال والحرام وما يتعلّق بالجانب العملي لسلوك الانسان، لكن الحقيقة أنّ التشريع يشمل كل المفاهيم التي ترتبط بالاعتقاد والأخلاق وسلوك الإنسان، وقد أشار القرآن بصورة صريحة إلى سعة وظيفة النبي وشموليتها لكل المجالات، قال تعالى:
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)([139]).
إذن وظيفة النبي| بيان الآيات القرآنية، ومن الواضح أنّ ما يتضمّنه القرآن من معارف لا تختصّ ببيان الحلال والحرام فحسب، إذ لا يشكّل البُعد العملي إلّا جزءاً يسيراً من حقائق القرآن، وليس لأحد أن يدّعي الاكتفاء بالقرآن في تلك الأبعاد المختلفة دون الرجوع لأحاديث النبي| وأقواله.
المقدّمة الثالثة: ضرورة الارتباط بالوسائط
لا يخفى على ذي مسكة أنّ هناك ارتباطاً بين غيب الغيوب ألا وهو الذات المقدّسة للبارئ تعالى وبين العوالم السفلية لا سيما عالم الإنسان، ولا بدّ لهذا الارتباط من رابطٍ يكون هو الآخر مخلوقاً لله تعالى. ويمثّل وجوب الاتصال وعدم الانقطاع بين العالم الربوبي والمخلوقات لا سيما الإنسان، عين التوحيد؛ لأنّ للتوحيد أنواعاً أحدها التوحيد في الأفعال، ومن أقسامه الأخرى التوحيد في التشريع والتقنين، والتوحيد في حقّ الطاعة، والتوحيد في الحاكمية والربوبية.
يمكن تصوّر ارتباط الله سبحانه مع مخلوقاته على نحوين:
1ـ الارتباط المباشر لله مع كل فرد دون واسطة، وهذا خلاف نظام الخلقة.
2ـ الارتباط بالواسطة عن طريق أفراد من البشر أو من الملائكة، وبما أنّهم يمثّلون الواسطة لفيض التشريع الإلهي لا بدّ أن يكونوا من البشر حتّى يصبحوا أسوة وقدوة لغيرهم، وعليه لا يمكن أن تكون الواسطة من الملائكة.
المقدّمة الرابعة: ضرورة وجود الأوصياء بعد الأنبياء
ربّما يسأل سائل: ألا يكفي وجود النبي للاتصال بالغيب والارتباط به بحيث لا تبقى ثمّة حاجة للأئمة والأوصياء من بعده؟
نقول في الجواب: إنّ ما نفهمه من الروايات ثبوت حقّ التشريع لكل إمام لكن لا بمعنى أنّ كل واحد منهم صاحب شريعة، بل إنّ هدايتهم بمثابة المتمّم للنبوة والرسالة والشريعة، لكن الهداية ـ بأيّ نحو كان ـ تتطلب العصمة لصاحبها.
ويعود ذلك إلى أنّ إحدى الامتيازات الأساسية في التقنين، بيان القوانين بصورة تدريجية، بمعنى وضع القانون في بادئ الأمر بصورة قاعدة عامّة وكلية، ثمّ يبدّل إلى قانون متوسط وأخيراً ينتهي إلى قانون يمكن تطبيقه في المجتمع. إنّ هذا النوع من التقنين الممارس في المحاكم نشاهده بعينه في الأديان السماوية بما فيها الإسلام، حيث يقيمه أولياء الله تعالى، هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك حاجة ملحّة لمراقبة عملية تنزيل القوانين والقواعد العامة وتطبيقها حتّى لا يختلط بعضها ببعض.
ولما كانت أعمار الأنبياء والرسل محدودة وفق السنّة التكوينية السائدة في نظام الخليقة، لذا يكتفون^ بذكر القواعد العامّة والكليّة ويتركون تفصيلها وتنفيذها لأشخاص آخرين معصومين يواصلون مسيرتهم؛ لأنّ سلامة الشريعة وحفظها يقتضي الاستمرار بمراقبتها في كل الأبعاد، لذا يستلزم الأمر وجود أشخاص لهم المعرفة بالقواعد العامّة والقوانين الكلية التي تترتب عليها مصالح البشر ومفاسدها فيقومون بأعباء هذه المهمّة ويطبقون تلك القوانين على المصاديق الجزئية سواء للفرد أو للمجتمع، خاصة أنّ الأحكام والأوامر الإلهية جارية في كل مجالات الحياة، وهذا ما يجعل المهمّة أصعب بكثير بحيث لا يمكن للإنسان الاعتيادي القيام بها من تشريع وتبيين وتطبيق.
بعد بيان هذه المقدّمات نصل إلى نتيجة مفادها الحاجة الماسّة إلى وجود أفراد معصومين بعد النبي|، وبعد كل نبي ينهضون بهذه المهمّة بشكل واسع، وأولئك الأفراد ـ في الإسلام ـ هم أهل بيت النبي| لا غيرهم، ومن ضمنهم الإمام الحسين×.
قال محمّد بن سنان:
«كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي× فَأَجْرَيْتُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ، ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً وَعَلِيّاً وَفَاطِمَةَ فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا وَأَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا وَفَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤونَ وَلَنْ يَشَاؤوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»([140]).
ومن هنا يقول الإمام المهدي#:
«قُلُوبُنَا أَوْعِيَةٌ لِمَشِيَّةِ اللهِ فَإِذَا شَاءَ شِئْنَا...»([141]).
13 ـ حاجة الإسلام لعصر التطبيق
الإسلام كغيره من الأديان السماوية، يحتاج إلى عصرٍ تُجرى فيه تعاليم الدين والشريعة الإسلامية يسمّى بـ(عصر التطبيق)؛ وذلك لأجل أن ينفذ في أعماق أتباعه؛ لأنّ دين الإسلام ظهر في وقت تنتشر فيه الجاهلية وتعمّ فيه تقاليدها واعتقاداتها الخرافية الباطلة التي سيطرت بصورة كبيرة يصعب فيها إخراج تلك الأمور من أذهان وقلوب المجتمع في شبه الجزيرة العربية بل وكافة الناس آنذاك.
ومن جانب آخر، إنّ الإسلام آخر الأديان السماوية المرسلة للمجتمع البشري والذي تطوى الحياة الدنيوية من بعده ليبدأ عالم آخر، أمّا بالنسبة إلى مدى امتداد عمر هذه البشرية في عصر ظهور الإسلام فعلمه عند الله تعالى.
إضافةً إلى ذلك، نرى أنّ عمر النبي| الذي جاء مبيّناً للشريعة وقاضياً على العادات والتقاليد الجاهلية كان محدوداً، فهل من الممكن القضاء على الرواسب الجاهلية من المجتمع البشري وإرساء الإسلام الأصيل وتعاليم الدين الحنيف على كل الأصعدة في فترة زمنية وجيزة كهذه؟ سيكون الجواب منفياً بالطبع.
من الأمور البديهية والضرورية لضمان تطبيق التعاليم الدينية وتنفيذ الشريعة بعد ظهور الدين الحاجة إلى شخص يتمتّع بما يلي:
أوّلاً: ذو نظرة شاملة جامعة، عارف بجميع حاجات البشر والمجتمع ومسدّد ببرنامج لذلك.
ثانياً: لا يضلّ في تطبيق الشريعة ولا يقع في الخطأ والاشتباه، خالٍ من رواسب الفكر الجاهلي وخرافاته، كي يستطيع إتمام وظيفة النبي في إيصال البشرية إلى الأهداف والمقاصد المنشودة، وهذه الصفات لا تتوفر إلّا في المعصوم الذي تمثّل في أفراد أهل بيت النبي|، ولذا كان النبي| منذ بدء رسالته يخطط لهذا العصر ويتخذ الخطوات اللازمة لذلك، فلم يكن من الصدفة أن يختار عليّاً من بين بني أبي طالب ويقوم بتربيته وتهذيبه. إنّ عمل الرسول هذا لا ينمّ إلّا عن أهمية مستقبل المرجعية الدينية عنده| وتثبيت الشريعة وتطبيقها من بعد رحيله بأفضل وأصحّ صورة ممكنة، ولا يتحقق ذلك البتّة إلّا بواسطة أهل البيت^ ومن جملتهم الإمام الحسين×.
الإسلام آخر دين سماوي ونبيّه آخر نبي، لذا أرسل إلى الأمم كافة، وأحاط بجميع أبعاد الحياة الفردية والاجتماعية. لكننا نعلم أنّ الفترة التي بُعث فيها النبي| كانت فترة محدودة للغاية، قد امتدت لـ 23 سنة قضى 13 منها في مكة المكرمة، المدينة التي كان لها السهم الأوفر في جهاد النبي ومبارزاته مع عبدة الأوثان وإبادة عقائد الشرك والوثنية، الأمر الذي حال دون نشر تعاليم الإسلام بصورة واسعة كي يتسنى تطبيقها على أرض الواقع، لذا عزم| على الهجرة إلى مدينة أخرى يكمل بها ما تبقى من عمر رسالته الشريفة ويتمتّع فيها بحرية أكثر تمكّنه من إجراء ما استطاع من تعاليم الدين الإسلامي، لكن تبقى العشر سنوات في المدينة المنورة فرصةً محدودةً لنبينا الكريم، خاصّةً وأنّ تلك الفترة فرضت على الرسول حروباً وغزوات كثيرة جعلته يقضي الكثير من وقته المبارك في إعداد العدّة والعدد لمواجهة الأعداء وتحكيم أسس الحكومة الإسلامية في المدينة المنوّرة الأمر الذي حال دون أن يستغرق النبي| وقته بأسره في بيان أحكام الشريعة.
ومن جانب آخر هناك ميزة تتمتّع بها الأديان والشرائع، وهي التدرّج في بيان الأحكام والتكاليف، فكما أنّ الأحكام لم تبيّن بأجمعها في صدر الإسلام بل كانت بصورة تدريجية طبقاً للمقتضى، فقد استمرت بتدريجيّتها هذه وبسعةٍ أكثر بعد رحيل الرسول|.
من هنا تجد المرجعية الدينية لأهل البيت^ ضرورتها، حيث تبيّن أحكام الشريعة في مكانها المناسب وتطرح الشريعة بصورة جزئية وواسعة بعد أن بيّنها الرسول| بصورة كلية، لكن بما أنّ أهل السنّة لم يعتقدوا بعصر التطبيق واكتفوا بسنّة رسول الله| فحسب، سرعان ما ظهرت عندهم الحاجة الماسّة إلى الأدلة العقلية والظنيّة كي يملؤوا الخلأ والفراغ الموجود، بينما الشيعة الإمامية ونتيجةً لاعتقادهم بأهل البيت^ وأخذهم أحكام الشريعة منهم لم يحتاجوا إلى أدّلة عقلية أو ظنيّة وأمضوا عصر التبيين في ظلّ المعصومين^.
قال الشهرستاني في الدليل على حجيّة القياس:
«نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات مما لا يقبل الحصر والعدّ، ونعلم قطعاً أيضاً أنّه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصور ذلك أيضاً، والنصوص إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، علم قطعاً أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد»([142]).
15 ـ ضرورة دوام عنصر التبيين بواسطة المعصوم
ما هي حيطة وحدود وظائف الأنبياء^؟ وبعد أن عرفنا أنّ لكل نبي وصيّ أو أوصياء، ما هي حيطة وظائف الأوصياء والحجج الإلهية بعد كل نبيّ؟ بقليل من التأمّل نصل إلى أنّ وظيفة الأنبياء مواجهة الانحرافات التي حصلت في أوساط الأمم السالفة، والاستمرار في إتمام الشريعة المتقدّمة، ومواصلة السير التكاملي للشرائع السماوية. وأمّا وظائف الأوصياء، فكانت بصدد توسعة وانتشار وتبيين الشريعة التي قام النبي ببيان أصولها للناس بصورة كلية، لذا نرى في التاريخ أنّ لكل نبيّ من أولي العزم^ أوصياء وحجج من بعده كي يقوموا بنشر شريعته وبسطها وتطبيقها على أرض الواقع.
يظنّ البعض مستندين على بعض الآيات القرآنية أنّ النبي الأكرم| هو من يقوم بتبيين الشريعة وقد أدّى ذلك بصورة كاملة، يقول تعالى:
(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) ([143]).
تدلّ الآية الكريمة على أنّ الدين قد تمّ على يد النبي| فلا حاجة في المقام إلى بيانه بواسطة أفراد أخر. نقول في الجواب:
أوّلاً: يستفاد من ظاهر الآية إتمام الدين على يد النبي الخاتم|: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)، وليس إتمام الشريعة، وهناك بون بين الدين والشريعة.
يبيّن القرآن الكريم أنّ الدين واحد والشرائع متعددة، لذا لم يستخدم لفظ الدين بصيغة الجمع أبداً؛ لأنّ الدين أمر واحد وحقيقته هي التسليم لله تعالى الذي له القوّة والسلطان وله الأهلية للعبادة، يقول النبي يوسف× لصاحبه في السجن بعد بيان انحصار الحكم بالله:
(ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)([144]).
لكن الشريعة في الاصطلاح، عبارة عن التعاليم العملية والأخلاقية التي تتعلّق بحياة الإنسان الفردية والاجتماعية ومسؤوليته أمام الله تعالى وأمام الناس، فلا يلزم من وحدانية الدين وحدانية الشرائع؛ لأنّ الشرائع تتضمّن أحكاماً وتعاليم سلوكية تتغيّر كماً وكيفاً تبعاً للمصالح ولمقتضيات الزمان والمكان، لذا يقول تعالى:
(لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)([145]).
ثانياً: لو فرضنا أنّ الأحكام والشريعة قد بيّنت على يد النبي|، ولكن لمّا كانت عادات الجاهلية وتقاليدها لم تنحسر من نفوس الناس، والتعاليم الإسلامية لم تأخذ قرارها في المجتمع، برزت الحاجة الملحّة لوجود أفراد معصومين ليحوّلوا تلك التعاليم الإسلامية بالتكرار والتأكيد إلى ملكات في المجتمع الإسلامي.
ثالثاً: يبتني الإشكال على أنّ المقصود من (الدين) في الآية الكريمة الأحكام الشرعية، وأنّ المراد من (الإكمال) بيان جميع الأحكام، وكلا التفسيرين باطل؛ لأنّ هذا التفسير لمعنى الآية يبتني على أمرين:
الأوّل: لم يكن نزول الآية على النبي في 18ذي الحجة، والثاني: عدم نزول أيّ حكم على النبي| بعد نزولها، وكلاهما لا يخلو من إشكال:
أمّا الادّعاء الأوّل فهو خلاف الواقع يقيناً؛ وذلك:
1ـ هناك قول في مقابل القول بنزول الآية في 18 ذي الحجة، يرى أنّ نزولها على النبي الخاتم’ كان في التاسع من ذي الحجة الحرام، وقد روي هذا عن عمر ابن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن العباس وعلي بن أبي طالب× وسمرة بن جندب، لكنها ضعيفة السند بأجمعها.
2ـ هناك عدد كبير من الصحابة يرى أنّ نزول الآية على النبي| كان في 18 من ذي الحجة.
3ـ القول بنزولها في التاسع من ذي الحجّة يخالف ما ذهب إليه أهل البيت^ الذين هم عِدل القرآن.
والادّعاء الثاني باطل أيضاً؛ وذلك لنزول فرائض أخرى على النبي| بعد آية (الإكمال) بناءً على نقل المفسرين.
حيث روى الطبري بسنده عن البراء بن عازب أنّ آية (الكلالة)([146]) هي آخر ما نزل على النبي| من القرآن فقال الله عزّ من قائل:
(يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ)([147]).
يقول أبو حيّان الأندلسي:
«قال الجمهور: وإكماله هو إظهاره، واستيعاب عظم فرائضه، وتحليله وتحريمه. قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير كآيات الربا، وآية الكلالة، وغير ذلك»([148]).
والنتيجة مما تقدّم: أنّ آية الإكمال نزلت على النبي| في الثامن عشر من ذي الحجّة، وليس المقصود من الدين أحكامه وفروعه، ولا المقصود من إكماله إتمام جميع مسائله الفرعية، بل المقصود من الدين أصول الإسلام، والمراد من إكماله تثبيت أركانه وإحكام قواعده التي لا تتحقق إلّا بتبليغ ولاية الإمام علي× وسائر الأئمة المعصومين من ولده وبيان مرجعيتهم الدينية. بعبارة أخرى: إنّ المراد من إكمال الدين انتقاله من حال الحدوث إلى البقاء، وهذا لا يتحقق إلّا بواسطة المرجعية الدينية لأهل البيت^ ومن جملتهم أبي عبد الله الحسين×.
تُعدّ آية المودّة من الآيات الدالّة على المقام السامي والمنزلة العظيمة لأهل البيت^ ومن جملتهم الإمام الحسين×.
قال الله تعالى:
(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)([149]).
لا شكّ بأنّ النبي| تحمّل الكثير من المصاعب طوال الـ(23) سنة في سبيل نشر عقيدة التوحيد، وهذا يقتضي أجراً عظيماً البتة، لكنّ النبي| لم يطلب من أمته أجراً على ذلك سوى المودة لأهل بيته^. نتناول في السطور البحث في الآية الكريمة التي تعدّ من فضائل أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين×.
الأحاديث الواردة بشأنها
قال ابن عباس:
«لَمَّا نَزَلَتْ: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ قَرَابَتُكَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ؟ قَالَ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا»([150]).
وروى الطبري بسنده عن أبي الديلم:
«لَمَّا جِيءَ بِعَلِيِّ بْنِ الحسَيْنِ×أَسِيراً، فَأُقِيمَ عَلَى دَرَجِ دِمَشْقَ، قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي قَتَلَكُمْ وَاسْتَأْصَلَكُمْ، وَقَطَعَ قُرْبَى الْفِتْنَةِ.
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الحسَيْنِ×: أَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: أَقَرَأْتَ آلْ حم؟ قَالَ: قَرَأْتُ الْقُرْآنَ وَلَمْ أَقْرَأَ آلْ حم.
قَالَ: مَا قَرَأْتَ(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)؟ قَالَ: وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ هُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ»([151]).
وروى الحاكم النيسابوري بسنده:
«خَطَبَ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّاسَ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ قُبِضَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ لَا يَسْبِقُهُ الْأَوَّلُونَ بِعَمَلٍ وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُعْطِيهِ رَايَتَهُ فَيُقَاتِلُ وَجِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَمَا تَرَكَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَايَاهُ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِماً لِأَهْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَأَنَا ابْنُ النَّبِيِّ، وَأَنَا ابْنُ الْوَصِيِّ، وَأَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ، وَأَنَا ابْنُ النَّذِيرِ، وَأَنَا ابْنُ الدَّاعِي إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ، وَأَنَا ابْنُ السِّرَاجِ المنِيرِ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي كَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ إِلَيْنَا وَيَصْعَدُ مِنْ عِنْدِنَا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِي افْتَرَضَ اللهُ مَوَدَّتَهُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا) فَاقْتِرَافُ الحسَنَةِ مَوَدَّتُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»([152]).
تدلّ آية المودّة من عدّة جهات على عظمة أهل البيت^ ومنهم الإمام الحسين×:
1 ـ وجوب المودّة يستلزم وجوب الطاعة
لم يكن مراد الآية الكريمة صرف المحبة والمودّة فحسب، بل إنّ الله تعالى يأمر بالمودّة التي يتبعها الانقياد والطاعة والامتثال، ويمكن إثبات ذلك من عدّة طرق:
أ) من لفظ المودّة نفسه؛ لأنّها تعني المحبة التي تتبعها الطاعة استناداً لرأي بعض اللغويين.
ب) من خلال الرجوع إلى بعض الآيات كما في قوله تعالى:
(قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ) ([153]).
والمقصود من الاتّباع في هذه الآية الطاعة والامتثال؛ لأنّ الله تعالى يقول في آية أخرى:
(وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي)([154]).
في هذه الآية وردت كلمة الطاعة معطوفة على كلمة الاتّباع عطفاً تفسيرياً.
يقول العلّامة الحلّي:
«وجوب المودّة يستلزم وجوب الطاعة»([155]).
2 ـ وجوب المحبّة المطلقة يستلزم الأفضلية
يُستفاد من الآية الكريمة أنّ أهل البيت^ بما فيهم الإمام الحسين× هم الذين تجب مودّتهم بصورة مطلقة ومن يكون كذلك لا بدّ أن يكون أحبّ الناس عند الله وعند رسوله، وبالتالي فهو الأفضل من بين أفراد الأمّة، وبهذا صرّح ابن حجر الهيتمي بقوله:
«فالمحبّة الدينية لازمة للأفضلية، فمن كان أفضل كانت محبتنا الدينية له أكثر»([156]).
3 ـ المحبّة المطلقة تلازم العصمة
أمر الله تعالى في هذه الآية بالمحبة المطلقة، والمحبة المطلقة تستلزم الطاعة، وهذا بمعنى أنّ الرسول| أمر بالطاعة المطلقة لأهل بيته، وبما أنّ الطاعة المطلقة تجب من المعصوم فحسب، إذن فالمقصود من ذوي القربى في الآية هم أهل بيت العصمة والطهارة، ولمّا كانوا معصومين ـ بما فيهم الإمام الحسين× ـ، فستكون المرجعية الدينية بعد رسول الله| لهم لا غير.
آية المباهلة من الآيات التي أشارت إلى فضيلة أهل البيت^ ومن جملتهم الإمام الحسين×، حيث خاطب الله نبيّه قائلاً:
(فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)([157]).
وهنا نناقش الروايات الواردة في شأن نزول الآية الكريمة لإثبات هذه الفضيلة لأهل البيت^ ومن بينهم الإمام الحسين×.
صيغة (المباهلة) مشتقة من مادة (بهل)، و(بَهَلَهُ الله) بمعنى (لَعَنَهُ الله)، ومعنى المباهلة: ملاعنة الطرفين أحدهما للآخر. وقد أورد بعض اللغويين في توضيح هذه الصيغة: المباهلة التضرّع والابتهال، والابتهال يأتي أحياناً لدفع البلاء وأحياناً لنزوله.
وكان هذا المعنى للمباهلة معروف في العرف العربي بشكل واضح، فلم تكن دعوة النبي| المسيحيين إلى المباهلة بدعاً من الفعل ولا باباً جديداً لإثبات الحق وإبطال الباطل، لذا كانت ردة فعل نصارى نجران طبيعية للغاية. وحتّى عندما جثا النبي| على ركبتيه ورفع يديه للدعاء قال أكبر أساقفتهم أبو حارثة: جثا والله كما جثا الأنبياء للمباهلة([158]).
وكان يؤتى بهذا الفعل بعد عدم الوصول إلى نتيجة من خلال الاحتجاجات والمباحثات، ويلجأ إليه لأجل القضاء على أحد الطرفين.
1ـ روى ابن عساكر بسنده عن أبي الطفيل مناظرة أمير المؤمنين× مع أصحاب الشورى، حيث احتجّ عليهم بجملةٍ من فضائله ومناقبه فكان من بينها قوله×:
«نَشَدْتُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ أَقْرَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي الرَّحِمِ، وَمَنْ جَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَفْسَهُ، وَأبْنَاءهُ أَبْنَاءَهُ، ونِسَاءهُ نِسَاءَهُ غَيْرِي؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا»([159]).
2ـ وروى أحمد بن حنبل بسنده:
«وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ)دَعَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلِيّاً، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَناً، وَحُسَيْناً رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلِي»([160]).
3ـ وروى مسلم:
«أَمَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْداً فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلَاثاً قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَلَنْ أَسُبَّهُ. لَأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ...
وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ)دَعَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلِيّاً وَفَاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي»([161]).
4ـ وروى الترمذي هذا الحديث أيضاً بنفس السند والنصّ، وصرّح بصحته([162]).
5ـ وروى الحاكم النيسابوري بسنده عن سعد بن أبي وقاص:
«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ)دَعَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلِيّاً وَفَاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناًF، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي»([163]).
6ـ وروى الطبري بسنده عن السدي في تفسير آية المباهلة:
«فَأَخَذَ، يَعْنِي النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِيَدِ الحسَنِ وَالحسَيْنِ وَفَاطِمَةَ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: اتْبَعْنَا، فَخَرَجَ مَعَهُمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ يَوْمَئِذٍ النَّصَارَى، وَقَالُوا: إِنَّا نَخَافُ...»([164]).
7ـ وذكر الشيخ المفيد أنّه:
«قَالَ المأْمُونُ يَوْماً لِلرِّضَا×: أَخْبِرْنِي بِأَكْبَرِ فَضِيلَةٍ لِأَمِيرِ المؤْمِنِينَ× يَدُلُّ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ الرِّضَا×: فَضِيلَتُهُ فِي المبَاهَلَةِ، قَالَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)فَدَعَا رَسُولُ اللهِ| الحسَنَ وَالحسَيْنَ÷ فَكَانَا ابْنَيْهِ، وَدَعَا فَاطِمَةَ‘ فَكَانَتْ فِي هَذَا الموْضِعِ نِسَاءَهُ، وَدَعَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ× فَكَانَ نَفْسَهُ بِحُكْمِ اللهِ}، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ سُبْحَانَهُ أَجَلَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ| وَأَفْضَلَ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ نَفْسِ رَسُولِ اللهِ| بِحُكْمِ اللهِ}»([165]).
وأمّا ما هي الفضائل الكامنة في هذه الآية والروايات المتعلّقة بها؟ فسنشير إلى جانب منها:
أ) تدلّ قضية المباهلة على أنّ أهل البيت^ ومن جملتهم الإمام الحسين× أحبّ الناس إلى رسول الله|، لذا يبيّن البيضاوي في تفسيره لهذه الآية:
«أي يدع كل منّا ومنكم نفسه وأعزّة أهله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة»([166]).
ب) إنّ إتيان النبي| بأولئك الأشخاص دون غيرهم للمباهلة مع ما في ذلك الموقف من حسّاسية وحاجة للدعاء فيه دلالة واضحة على أفضليتهم على الآخرين.
ج) ينقل الزمخشري:
«... فَأَتَى رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَقَدْ غَدَا مُحْتَضِناً الحسَيْنَ آخِذاً بِيَدِ الحسَنِ وَفَاطِمَةُ تَمْشِى خَلْفَهُ وَعَلَىٌ خَلْفَهَا وَهُوَ يَقُولُ: (إِذَا أَنَا دَعَوْتُ فَأَمِّنُوا). فَقَالَ أُسْقُفُ نَجْرَانَ: يَا مَعْشَرَ النَّصَارَى، إِنِّي لَأَرَى وُجُوهاً لَوْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُزِيلَ جَبَلاً مِنْ مَكَانِهِ لَأَزَالَهُ بِهَا، فَلَا تُبَاهِلُوا فَتَهْلِكُوا وَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ نَصْرَانِيٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...»([167]).
نستوحي من هذا النص أنّ النصارى قد أدركوا فضيلة أهل البيت^ أيضاً.
من الآيات الدالّة على فضائل أهل البيت^ ومنهم الإمام الحسين×، الآية المعروفة بآية (الإطعام)، يقول الله تعالى:
(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا)([168]).
يقول ابن عباس:
«إِنَّ الحسَنَ وَالحسَيْنَ مَرَضَا، فَعَادَهُمَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي نَاسٍ مَعَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الحسَنِ، لَوْ نَذَرْتَ عَلَى وُلْدِكَ، فَنَذَرَ عَلِىٌّ وَفَاطِمَةُ وَفِضَّةٌ جَارِيَةٌ لَهُمَا إِنْ بَرَآ مِمَّا بِهِمَا أَنْ يَصُومُوا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَشَفَيَا وَمَا مَعَهُمْ شَيْءٌ، فَاسْتَقْرَضَ عَلِىٌّ مِنْ شَمْعُونِ الخيْبَرِيِّ الْيَهُودِيِّ ثَلَاثَة أَصْوُعٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَطَحَنَتِ فَاطِمَةُ صَاعاً وَاخْتَبَزَتْ خَمْسَةَ أَقْرَاصٍ عَلَى عَدَدِهِمْ، فَوَضَعُوهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لِيُفْطِرُوا فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ سَائِلٌ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، مِسْكِينٌ مِنْ مَسَاكِينِ المسْلِمِينَ، أَطْعِمُونِي أَطْعَمَكُمُ اللهُ مِنْ مَوَائِدِ الجنَّةِ، فَآثَرُوهُ وَبَاتُوا لَمْ يَذُوقُوا إِلَّا الماءَ، وَأَصْبَحُوا صِيَاماً، فَلَمَّا أَمْسَوْا وَوَضَعُوا الطَّعَامَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ يَتِيمٌ، فَآثَرُوهُ، وَوَقَفَ عَلَيْهِمْ أَسِيرٌ فِي الثَّالِثَةِ، فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا أَخَذَ عَلِىٌّE بِيَدِ الحسَنِ وَالحسَيْنِ وَأَقْبَلُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَلَمَّا أَبْصَرَهُمْ وَهُمْ يَرْتَعِشُونَ كَالْفِرَاخِ مِنْ شِدَّةِ الجوعِ قَالَ: مَا أَشَدَّ مَا يَسُوؤُنِي مَا أَرَى بِكُمْ، وَقَامَ فَانْطَلَقَ مَعَهُمْ فَرَأَى فَاطِمَةَ فِي مِحْرَابِهَا قَدْ الْتَصَقَ ظَهْرُهَا بِبَطْنِهَا وَغَارَتْ عَيْنَاهَا. فَسَاءَهُ ذَلِكَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَقَالَ: خُذْهَا يَا مُحَمَّدُ هَنَّأَكَ اللهُ فِي أَهْلِ بَيْتِكَ فَأَقْرَأَهُ السُّورَةِ»([169]).
روى شأن النزول هذا كثيرٌ من علماء أهل السنّة، نشير إلى بعضها:
1ـ ذكر ابن عبد ربّه الأندلسي ضمن حديث احتجاج المأمون ـ الخليفة العباسي ـ على أربعين فقيهاً:
«قال: يا إسحاق، هل تقرأ القرآن؟ قلت: نعم، قال: اقرأ عليّ (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا)([170]) فقرأت منها حتّى بلغت (يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا)([171]) إلى قوله: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)([172]) قال: على رسلك، فيمن أنزلت هذه الآيات؟ قلت: في عليّ. قال: فهل بلغك أنّ علياً حين أطعم المسكين واليتيم والأسير قال: إنّما نطعمكم لوجه الله؟ وهل سمعت الله وصف في كتابه أحداً بمثل ما وصف به علياً؟ قلت: لا. قال: صدقت، لأنّ الله جلّ ثناؤه عرف سيرته. يا إسحاق، ألست تشهد أنّ العشرة في الجنة؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين. قال: أرأيت لو أنّ رجلاً قال: والله ما أدري هذا الحديث صحيح أم لا، ولا أدري إن كان رسول الله قاله أم لم يقله، أكان عندك كافراً؟ قلت: أعوذ بالله! قال: أرأيت لو أنّه قال: ما أدري هذه السورة من كتاب الله أم لا، كان كافراً؟ قلت: نعم. قال: يا إسحاق، أرى بينهما فرقاً»([173]).
2ـ يقول أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعي في ذلك:
«ومما اعتمده من الطاعة وسارع فيه إلى العبادة ما رواه الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي وغيره من أئمة التفسير... فكفى بهذه عبادةً وبإطعام هذا الطعام مع شدّة حاجتهم إليه منقبةً ولو لا ذلك لما عظمت هذه القصة شأناً وعلت مكاناً ولما أنزل الله (تعالى) فيها على رسول الله| قرآناً»([174]).
3ـروى سبط ابن الجوزي في كتابه (تذكرة الخواص) رواية إطعام أهل البيت^ عن طريق البغوي والثعلبي، ثمّ يعترض على جدّه ابن الجوزي لماذا جعل هذا الحديث من (الموضوعات)؟ ثم ينزّه سند الرواية ويقول:
«والعجب من قول جدّي وإنكاره»([175]).
ويقول أيضاً:
«قال علماء التأويل: فيهم نزل...»([176]).
4ـ وقال شمس الدين القرطبي في تفسيره لهذه الآية:
«وقال أهل التفسير: نزلت في علي وفاطمةG وجارية لهما اسمها فضة»([177]).
5ـواختار عبد الله بن أحمد النسفي هذا القول من بين الأقوال، وذكره قائلاً:
«نزلت في عليّ وفاطمة وفضة جارية لهما لما مرض الحسن والحسينG نذروا صوم ثلاثة أيام، فاستقرض عليّE من يهوديّ ثلاثة أصوع من الشعير، فطحنت فاطمةO كلّ يوم صاعاً وخبزت، فآثروا بذلك ثلاث عشايا على أنفسهم مسكيناً ويتيماً وأسيراً ولم يذوقوا إلّا الماء في وقت الإفطار»([178]).
6ـكما يقول نظام الأعرج النيسابوري:
«ذكر الواحدي في البسيط والزمخشري في الكشاف، وكذا الإمامية أطبقوا على أنّ السورة نزلت في أهل بيت النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا سيما في هذه الآية...».
ويُروى أنّ السائل في الليالي جبرئيل أراد بذلك ابتلاءهم بإذن الله سبحانه([179]).
7ـوقال محمود بن عبد الله الآلوسي في تفسيره لآية (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا):
«وما ذا عسى يقول امرؤ فيهما سوى أنّ علياً مولى المؤمنين ووصي النبي، وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدي، وأمّا الحسنان فالروح والريحان وسيّدا شباب الجنان، وليس هذا من الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الغيّ:
|
أنا عبد الحق لا عبد الهوى |
ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أنّه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنّما صرّح بالولدان المخلدين رعاية لحرمة البتول وقرّة عين الرسول»([180]).
قال الله تعالى:
(آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) ([181]).
روى السيوطي بسنده عن الإمام علي× أنّه قال:
«سَأَلْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَنْ قَوْلِ اللهِ:(فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ)فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَهْبَطَ آدَمَ بِالْهِنْدِ وَحَوَّاءَ بِجَدَّةَ... حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ جِبْرِيلُ وَقَالَ: يَا آدَمُ أَلَمْ أَخْلُقْكَ بِيَدَيَّ؟ أَلَمْ أَنْفُخْ فِيكَ مِنْ رُوحِي؟ أَلَمْ أُسْجِدْ لَكَ مَلَائِكَتِي؟ أَلَمْ أُزَوِّجْكَ حَوَّاءَ أَمَتِي؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا هَذَا الْبُكَاءُ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ الْبُكَاءِ وَقَدْ أُخْرِجْتُ مِنْ جِوَارِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: فَعَلَيْكَ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَإِنَّ اللهَ قَابِلٌ تَوْبَتَكَ وغَافِرٌ ذَنْبَكَ. قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءاً وَظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ... فَهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتُ الَّتِي تَلَقَّى آدَمُ»([182]).
5 ـ الولاية التكوينية للإمام الحسين×
من الأبحاث التي كانت ولا زالت دائرة بين المتكلمين بحث الولاية التكوينية. فما هي الولاية؟ وما معنى الولاية التكوينية؟ وهل يمكن لشخصٍ غير الأنبياء أن تكون له ولاية تكوينية فيصبح له حقّ التصرّف في نظام التكوين؟
نشرع هنا ببيان هذا الموضوع وشرحه.
1ـ قال الفيومي في ذلك:
«الوَلْيُ مثل فَلْس: القرب... والولاية بالفتح والكسر: النصرة»([183]).
2ـ وقال الجوهري:
«الوَلْيُ: القرب والدنوّ... وكل من ولي أمر واحد فهو وليه... والولاية بالكسر: السلطان. والوَلاية والوِلاية: النصرة»([184]).
3ـ وجاء في (أقرب الموارد):
«الوَلْي حصول الثاني بعد الأوّل من غير فصل. وَلِيَ الشيءَ وعليهِ وِلايَةً ووَلايَةً: ملك أمره وقام به أو الوَلايَة بالفتح المصدر وبالكسر الخطّة والإمارة والسلطان...»([185]).
4ـ قال الراغب الإصفهاني:
«الْوَلَاءُ والتَّوَالِي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما»([186]).
5ـ وفي المعنى الاصطلاحي (للولاية) قال العلّامة الطباطبائي:
«وإنّها هي الكمال الأخير الحقيقي للإنسان وإنّها الغرض الأخير من تشريع الشريعة الحقّة الإلهية»([187]).
6ـ وذكر في تفسير (الميزان):
«والولاية وإن ذكروا لها معاني كثيرة لكن الأصل في معناها ارتفاع الواسطة الحائلة بين الشيئين بحيث لا يكون بينهما ما ليس منهما، ثمّ استعيرت لقرب الشيء من الشيء بوجهٍ من وجوه القرب كالقرب نسباً أو مكاناً أو منزلة أو بصداقة أو غير ذلك، ولذلك يطلق الولي على كل من طرفي الولاية، وخاصة بالنظر إلى أنّ كلا منهما يلي من الآخر ما لا يليه غيره، فالله سبحانه ولي عبده المؤمن؛ لأنّه يلي أمره ويدبر شأنه فيهديه إلى صراطه المستقيم ويأمره وينهاه فيما ينبغي له أو لا ينبغي وينصره في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والمؤمن حقاً وليّ ربّه؛ لأنّه يلي منه إطاعته في أمره ونهيه ويلي منه عامة البركات المعنوية من هداية وتوفيق وتأييد وتسديد وما يعقبها من الإكرام بالجنة والرضوان»([188]).
معنى الولاية التكوينية
الولاية التكوينية هي القدرة على التصرّف في العالم بما فيه الإنسان بإذن الله تعالى، وتتحقق هذه الولاية للفرد بعد أن يطوي طريق العبودية حتّى يبلغ الدرجات السامية من الكمال والقرب المعنوي.
فـ(الولاية التكوينية) عبارة عن كمالٍ روحيّ ومعنويّ يتحقق للإنسان في ظلّ عمله وفق النواميس الإلهية والقوانين الشرعية فيكون ذلك الكمال مصدراً لكثير من الأفعال الخارقة للعادة. ويكون الباب مفتوحاً بمصراعيه أمام الجميع في هذه الولاية لطيّ مراتبها والرقيّ بدرجاتها باعتبارها كمالاً وواقعاً اكتسابياً، بخلاف الولاية التشريعية فإنّها وجميع مراتبها عبارة عن مواهب إلهية لا تتحقق لفرد إلّا بإرادة الله تعالى وذلك بعد الحصول على الكثير من التمهيدات التي تجعل الفرد أهلاً لمنحه حقّ التشريع من قبل الحقّ تعالى.
الولاية التكوينية في المنظور القرآني
من الشواهد القرآنية على الولاية التكوينية لأولياء الله تعالى ما يلي:
1ـ ينقل الوحي الكريم خطاب النبي يوسف× لإخوته:
(اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا) ([189]).
ويقول في آية أخرى:
(فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا) ([190]).
يُستفاد من الآية الكريمة مدى تأثير إرادة النبي يوسف× وقدرته الروحية في إعادة البصر لأبيه×.
2ـ كما يحدّثنا تعالى عن النبي موسى×:
(وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ) ([191]).
3ـ وعندما أحضر النبي سليمان× ملكة سبأ، قال للحضور قبل قدومها:
(يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ)([192]).
فأجابه أحدهم سآتيك به قبل أن تقوم من مكانك وإنّني على ذلك لقويّأمين، وأعلن آخر يدعى (آصف بن برخيا) عن استعداده بإحضار العرش قبل أن يغمض النبي عينه. يصف الوحي ذلك الموقف بقوله تعالى:
(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي)([193]).
4ـ نسب القرآن الكريم بعض المعاجز إلى النبي عيسى× تشير بأجمعها إلى أنّ عيسى× كان يقوم بتلك الأفعال بقوته الباطنية وبإرادته الخلّاقة، كما في قوله تعالى:
(أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ)([194]).
5ـ يصرّح القرآن بإحدى المعاجز والأفعال التكوينية التي جرت على يد نبينا محمد| فيقول:
(اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ)([195]).
ينقل الطبرسي في بيانه لشأن نزول الآيات الكريمة أعلاه أنّ ابن عباس قال:
«اِجْتَمَعَ المشْرِكُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ| فَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَشُقَّ لَنَا الْقَمَرَ فِرْقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ: إِنْ فَعَلْتُ تُؤْمِنُونَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ بَدْرٍ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ| رَبَّهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَا قَالُوا فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ»([196]).
والحقّ أنّ المعجزة فعل ولي الله يقوم به بإذن الله ومشيئته، وعليه فإنّ المقصود من (وَانْشَقَّ الْقَمَرُ)في الآية الأولى هو المعجزة والتصرّف التكويني الذي قام به النبي| في حادثة شقّ القمر المذكورة في الأخبار. لعلنا نذهب إلى أنّ انشقاق القمر في الآيات الكريمة يعود إلى وقوع ذلك يوم القيامة، لكن القرائن تشير إلى ما ذهب إليه الرأي الأوّل، من قبيل:
أ) عبارة (وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا)تحكي عن أنّ المقصود هنا ليست الآيات القرآنية، بل المقصود المعجزة؛ لأنّ القرآن الكريم عبّر عن معاجز الأنبياء بلفظ (الآية) أو (البيّنة)، ولو كان المراد الآيات القرآنية لكان الأنسب أن يعبّر بدل فعل (يرَوْا) بأفعال مثل: (وَإِنْ سَمِعُوا) أو (وَإِنْ نَزَلَتْ آيةٌ)، إذن المقصود من الآية، إعجاز النبي| وانشقاق القمر.
ب) عبارة (وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ)دليل على هذا المعنى أيضاً، وهو أنّ الحديث في الآيات الكريمة يعود إلى معجزة النبي| وليس لانشقاق القمر يوم البعث؛ لأنّ رمي آيات القرآن بالسحر أمر باطل ولا يجري الباطل على لسان أحدٍ يوم القيامة الذي تظهر فيه حقائق الأمور.
والحاصل من ملاحظة القرائن المذكورة وسبب نزول الآيات الكريمة، أنّ الآيات الأولى من سورة القمر تشير إلى إحدى معاجز النبي| المعروفة بشقّ القمر وتصرّفه في الكون الناشئ من ولايته التكوينية.
الولاية التكوينية للإمام الحسين× من وجهة نظر القرآن الكريم
يمكن إثبات الولاية التكوينية للإمام الحسين× من خلال بعض المقدّمات:
كما ذكرنا سابقاً أنّ النبي سليمان× قال لأحد الحضور في مجلسه: من يأتيني بعرش بلقيس قبل أن تأتيني وقومها مطيعين؟ فأعلن (آصف بن برخيا) استعداده لإحضار العرش بطرفة عين. يذكر القرآن الكريم تلك الحادثة بالنحو التالي:
(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي)([197]).
يستفاد من الآية الكريمة بصورة واضحة أنّ من عنده علم من الكتاب لديه قدرة التصرّف في الكائنات، وهذه هي الولاية التكوينية.
يقول تعالى في آية أخرى:
(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)([198]).
نستفيد من هذه الآية الكريمة أنّ الله تعالى ومن عنده علم الكتاب شهداء بين النبي والناس. كما يستفاد من الآية أنّ هناك جمعاً يعلم بكل الكتاب بدلالة (مَن) الموصولة التي تفيد العموم، هذا من جانب، ومن جانب آخر كلمة (علم) مصدر وقد بُيّن في علم أصول الفقه أنّ المصدر المضاف يفيد العموم في نظر بعض العلماء، وكذا بالنسبة للرأي القائل بدلالة المفرد المحلّى بـ(الأف واللام). إذن يدلّ (علم الكتاب) على العموم من جهتين، ونستنتج من ذلك: أنّ هناك جماعة عالمة ومطلعة على كلّ الكتاب.
نقرأ في كتاب الله قوله:
(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)([199]).
هناك احتمالان في (* لَا يَمَسُّهُ): أحدهما المسّ الظاهري بأجزاء البدن، والآخر المسّ الباطني، كما أنّ هناك احتمالين أيضاً في (الْمُطَهَّرُونَ): أحدهما الطهارة الظاهرية لأجزاء البدن، والأخرى الطهارة الباطنية للقلب.
من هم المطهّرون في هذه الآية؟ عندما نرجع إلى كتاب الله نجده يقول:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) ([200]).
حيث تعيّن الآية الشريفة مصداق المطهّرين بالذات، وهم أهل بيت النبي| لا غير.
ولتحديد مصداق أهل البيت لا بدّ من الرجوع إلى الروايات؛ لأنّ الله تعالى يقول في كتابه:
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)([201]).
بعد الرجوع إلى روايات الفريقين من السنّة والشيعة نصل إلى أنّ المقصود من أهل البيت في الآية الكريمة هم النبي| وعلي وفاطمة والحسنين^. وبما أنّ الحصر في الآية إضافي فإنّه يخرج زوجات النبي| وبقية أصحابه من شمول الآية الكريمة. وفي النتيجة تكون آية التطهير شاملة لكل أهل البيت^ بما فيهم الاثني عشر إماماً.
1ـ روى مسلم بسنده عن عائشة:
«خَرَجَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الحسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) »([202]).
2ـ كما روى الترمذي بسنده عن أم سلمة:
«أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جَلَّلَ عَلَى الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، أَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً»([203]).
3ـ وروى أيضاً عن عمر بن أبي سلمة (ربيب النبي|):
«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ»([204]).
4ـ وروى بسنده أيضاً عن أنس بن مالك:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ إِلَى صَلَاةِ الفَجْرِ يَقُولُ: الصَّلَاةَ يَا أَهْلَ البَيْتِ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) »([205]).
5ـ وروى أحمد بن حنبل بسنده عن أم سلمة:
«أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَانَ فِي بَيْتِهَا، فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِبُرْمَةٍ، فِيهَا خَزِيرَةٌ، فَدَخَلَتْ بِهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: ادْعِي زَوْجَكِ وَابْنَيْكِ. قَالَتْ: فَجَاءَ عَلِيٌّ، وَالحسَيْنُ، وَالحسَنُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، فَجَلَسُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تِلْكَ الخزِيرَةِ، وَهُوَ عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ عَلَى دُكَّانٍ تَحْتَهُ كِسَاءٌ خَيْبَرِيٌّ. قَالَتْ: وَأَنَا أُصَلِّي فِي الحجْرَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) قَالَتْ: فَأَخَذَ فَضْلَ الْكِسَاءِ، فَغَشَّاهُمْ بِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ، فَأَلْوَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً، اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً.
قَالَتْ: فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْبَيْتَ، فَقُلْتُ: وَأَنَا مَعَكُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ، إِنَّكِ إِلَى خَيْرٍ»([206]).
نخرج من هذه المقدّمات بنتيجة مفادها أنّ أهل البيت^ ومن ضمنهم الإمام الحسين× لديهم ولاية تكوينية تمنحهم قدرة التصرّف في العالم بإذن الله تعالى.
6 ـ الفضائل المشتركة مع باقي الأئمة^
ذكرت الروايات بعض الفضائل المشتركة بين الإمام الحسين× وسائر الأئمة^، من قبيل:
محبّة أهل البيت^ في الروايات
أكّدت روايات الفريقين ـ كما أكّد القرآن الكريم ـ على محبة أهل البيت^ ومن جملتهم الإمام الحسين×، نشير إلى بعضها:
1 ـ الحثّ على محبّة أهل البيت^
يقول رسول الله|:
«أدِّبُوا أوْلادَكُمْ على ثلاثِ خِصالٍ: حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ أهْلَ بَيْتِهِ وقِراءَةِ القُرآنِ»([207]).
كما يقول أمير المؤمنين×:
«أَحْسَنُ الحسَنَاتِ حُبُّنَا وَأَسْوَءُ السَّيِّئَاتِ بُغْضُنَا»([208]).
2 ـ حبّ أهل البيت^ هو الحبّ لرسول اللّه |
1ـ قال رسول الله|:
«أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ، وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللهِ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي»([209]).
2ـ يقول زيد بن أرقم:
«كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جَالِساً فَمَرَّتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا كَلِيمٌ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ بَيْتِهَا إلَى حُجْرَةِ نَبِيِّ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَمَعَهَا ابْنَاهَا الحسَنُ وَالحسَيْنُ وَعَلِيٌّ فِي أَثَارِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقَالَ: «مَنْ أَحَبَّ هَؤُلَاءِ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنِي»([210]).
3ـ وعن الإمام الصادق×:
«مَنْ عَرَفَ حَقَّنَا وَأَحَبَّنَا فَقَدْ أَحَبَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى»([211]).
3 ـ حبّ أهل البيت^ أساس الإيمان
قال رسول الله|:
«وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي»([212]).
وقال أيضاً:
«وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»([213]).
4 ـ حبّ أهل البيت^ عبادة
قال رسول الله|:
«حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ يَوْماً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ، وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الجنَّةَ»([214]).
5 ـ محبّة أهل البيت^ علامة الإيمان
قال رسول الله|:
«لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ»([215]).
6 ـ محبّة أهل البيت^ علامة على طهارة المولد
أشار النبي| في يوم خيبر إلى علي× وقال:
«يَا أَيُّهَا النَّاسُ امْتَحِنُوا أَوْلَادَكُمْ بِحُبِّهِ فَإِنَّ عَلِيّاً لاَ يَدْعُو إِلَى ضَلَالَةٍ وَلَا يَبْعُدُ عَنْ هُدًى، فَمَنْ أَحَبَّهُ فَهُوَ مِنْكُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ فَلَيْسَ مِنْكُمْ»([216]).
وروى أمير المؤمنين× عن النبي| قوله لأبي ذر:
«يَا أَبَا ذَرٍّ، مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا أَوَّلُ النِّعَمِ؟ قَالَ: طِيبُ الْوِلَادَةِ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا مَنْ طَابَ مَوْلِدُهُ»([217]).
7 ـ السؤال عن محبّة أهل البيت^ يوم القيامة
قال رسول الله|:
«أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»([218]).
وقال أيضاً:
«لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ، وَعَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»([219]).
إذ يستفاد من روايات الفريقين المشاركة في الصلوات على النبي وآله في الصلاة:
1ـ روي عن كعب بن عجرة أنّ رسول الله| يقول في الصلاة:
«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»([220]).
2ـ لا شك في وجوب اتّباع النبي| في الصلاة؛ لأنّه| قال:
«وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»([221]).
3ـ روى أبو مسعود الأنصاري أنّ النبي|:
«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ»([222]).
4ـ قال عقبة بن عمرو:
«أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ. فَقَالَ: إِذَا أَنْتُمْ صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»([223]).
5ـ وروى ابن مسعود عن رسول الله| أنّه قال:
«إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حُمَيْدٌ مَجِيدٌ»([224]).
1ـ قال أبو مسعود الأنصاري:
«أَتَانَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: أَمَرَنَا اللهُ تَعَالَى أَن نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»([225]).
2ـ يقول أبو سعيد الخدري:
«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا التَّسْلِيمُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ»([226]).
3ـ قال ابن عباس:
«فَقُلْنَا: أَوْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حُمَيْدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حُمَيْدٌ مَجِيدٌ»([227]).
وروى الإمام علي× هذا المضمون أيضاً عن رسول الله|([228]).
4ـ قال طلحة:
«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»([229]).
5ـ روى زيد بن خارجة عن النبي| قوله:
«صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، وَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»([230]).
6ـ يروي بريدة الخزاعي عن رسول الله| حول كيفية الصلاة أنّه قال:
«قُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا جَعَلْتَهَا عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»([231]).
7ـ قالت عائشة:
«قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): يَا رَسُولَ اللهِ أُمِرْنَا أَنْ نُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ، وَأُحِبَّ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْكَ كَمَا تُحِبُّ، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ، وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ، كَمَا رَحِمْتَ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَآلِ إبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَأمَّا السَّلَامُ فَقَدْ عَرَفْتُمْ كَيْفَ هُوَ»([232]).
8ـ قال ابن حجر الهيتمي:
«يُرْوَى: لَا تُصَلُّوا عَليَّ الصَّلَاةَ الْبَتْرَاءَ. فَقَالُوا: وَمَا الصَّلَاةُ الْبَتْرَاءُ؟ قَالَ: تَقُولُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَتُمْسِكُونَ، بَلْ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»([233]).
9ـ وقال كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى:
«أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي، فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»([234]).
10ـ قال أبو هريرة:
«قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ»([235]).
عندما نرجع إلى الروايات نجدها تبيّن أنّ المقصود من أهل البيت هم الأئمة المعصومون^.
1ـ روى مسلم بسنده عن عائشة:
«خَرَجَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ، مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ، فَجَاءَ الحسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ الحسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)»([236]).
2ـ كما روى الترمذي في صحيحه عن عمر بن أبي سلمة:
«لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَناً وَحُسَيْناً فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ، وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيراً، قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ»([237]).
3ـ وروى أحمد بن حنبل بسنده:
«وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ)دَعَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلِيّاً، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَناً، وَحُسَيْناً رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلاءِ أَهْلِي»([238]).
لا يخفى أنّ الأربعة من أهل البيت^ كانوا موضع اهتمام من قبل النبي| ولا خصوصية لذلك، وإن ورد الحصر في بعض الروايات فهو حصر إضافي بالنسبة لغير المعصومين وليس حصراً حقيقياً، ومن جانبٍ آخر فإنّه لما كان هؤلاء الأربعة من أهل البيت^ حاضرين، وجّه تعالى الخطاب إليهم.
يقول الفخر الرازي:
«آل محمّد (صلى الله عليه وسلّم) هم الذين يؤول أمرهم إليه فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل، ولا شك أنّ فاطمة وعلياً والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أشد التعلّقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل...»([239]).
وقال الحاكم النيسابوري بعد نقله لحديث كعب بن عجرة:
«وإنّما خرجته ليعلم المستفيد أنّ أهل البيت والآل جميعاً هم»([240]).
كما أفرد البيهقي باباً تحت عنوان (باب بيان أهل بيته الذين هم آله)([241]).
يقول ابن طلحة الشافعي:
«فالنبي| فسر أحدهما بالآخر، فالمفسر والمفسر به سواء في المعنى، فقد أبدل لفظاً بلفظ مع اتحاد المعنى فيكون آله أهل بيته وأهل بيته آله، فيتحدان في المعنى على هذا القول. ويكشف حقيقة ذلك أنّ أصل آل أهل فأبدلت الهاء همزة، ويدل عليه أنّ الهاء ترد في التصغير فيقال في تصغير آل: أهيل، والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها»([242]).
قال ابن تيمية:
«والصحيح أنّ آل محمّد هم أهل بيته، وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد»([243]).
كما ذكر ابن الأثير في كتابه (النهاية):
«قد اختلف في آل النبي (صلى الله عليه وسلم): فالأكثر على أنّهم أهل بيته»([244]).
أعداء أهل البيت^ من أهل جهنم
روى أبو سعيد الخدري عن النبي| أنّه قال:
«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْغَضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ»([245]).
وقد ذكر حسن بن علي السقّاف الشافعي في (صحيح شرح العقيدة الطحاوية) هذا الحديث وادّعى صحته([246]).
7 ـ الفضائل المشتركة مع أصحاب الكساء
وأمّا الفضائل التي ذكرتها الروايات للإمام الحسين× والتي يشترك فيها مع بقية أصحاب الكساء عبارة:
قال النبي الأكرم| مخاطباً علياً وفاطمة والحسن والحسين^:
«أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ»([247]).
عن أمير المؤمنين علي×:
«أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَخَذَ بِيَدِ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّنِي وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»([248]).
وعبّر الترمذي عن هذا الحديث بعد نقله بأنّه (حَسَن).
8 ـ الفضائل المشتركة بين الإمام الحسن والإمام الحسين÷
ذكرت الروايات بعض الفضائل المشتركة بين الإمامين الحسن والحسين÷، من قبيل:
روى الطبراني بسنده عن ربعي بن حراش عن الإمام علي×:
«أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَقَدْ بَسَطَ شَمْلَةً، فَجَلَسَ عَلَيْهَا هُوَ وَفَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَالحسَنُ وَالحسَيْنُ، ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِمَجَامِعِهِ، فَعَقَدَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْضَ عَنْهُمْ كَمَا أَنَا عَنْهُمْ رَاضٍ»([249]).
روى عبد الله بن عمر عن النبي| أنّه قال عن الإمامين الحسن والحسين÷:
«هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»([250]).
وقد صحّح الترمذي هذا الحديث بعد نقله.
روى أحمد بن حنبل بسنده عن عطاء:
«أَنَّ رَجُلاً أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَضُمُّ إِلَيْهِ حَسَناً وَحُسَيْناً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا»([251]).
وقال الهيثمي بعد نقله هذا الحديث:
«رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح»([252]).
د) أمر النبي| بمحبّتهما
إذ يقول عبد الله بن مسعود:
«كَانَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يُصَلِّي وَالحسَنُ وَالحسَيْنُ يَثِبَانِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيُبَاعِدُهُمَا النَّاسُ، فَقَالَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): دَعُوهُمَا، بِأَبِي هُمَا وَأُمِّي مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ هَذَيْنِ»([253]).
ويرى ناصر الدين الألباني في كتابه (صحيح موارد الظمآن) أنّ هذا الحديث حسن([254]).
قال أبو هريرة:
«خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَمَعَهُ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً، وهَذَا مَرَّةً، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي»([255]).
وقد صحح الهيثمي هذا الحديث في (مجمع الزوائد) ([256]).
روى الترمذي بسنده عن أسامة بن زيد أنّه قال:
«طَرَقْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الحاجَةِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فَكَشَفَهُ، فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَى وَرِكَيْهِ، فَقَالَ: هَذَانِ ابْنَايَ وَابْنَا ابْنَتِيَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا، وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا»([257]).
وعدّ الترمذي هذا الحديث حسناً، وقال ابن حجر العسقلاني أيضاً في ترجمة الحسن بن أسامة بعد نقله كلام الترمذي: «وصححه ابن حبان والحاكم»([258]).
ويعتقد الألباني أيضاً بأنّه حسن([259]).
وكذا الهيثمي حيث روى عن أبي هريرة أنّه قال:
«أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، سَمِعَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الحسَنَ وَالحسَيْنَ وَهُمَا يَبْكِيَانِ، وَهَمَا مَعَ أُمِّهِمَا، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَتَاهُمَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا شَأْنُ ابْنَيَّ؟...»([260]).
وقال الهيثمي بعد نقله لهذا الحديث:
«رواه الطبراني، ورجاله ثقات»([261]).
كما تعدّ آية المباهلة شاهد صدقٍ على هذا المدّعى، حيث جاء فيها (نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ)، فأخرج النبي| معه الإمامين الحسن والحسين÷.
وروى عن النبي| أنّه قال:
«لِكُلِّ بَنِي أُمِّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِمْ إِلَّا ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا»([262]).
كما روى هذا المضمون أيضاً كل من الطبراني في (المعجم الكبير)([263])، والسيوطي في (جامع الأحاديث)([264])، وأبو يعلى في مسنده([265]).
روى الحاكم النيسابوري بسنده عن سلمان أنّه سمع رسول الله| يقول:
«الحسَنُ وَالحسَيْنُ ابْنَايَ، مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللهُ أَدْخَلَهُ الجنَّةَ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللهُ أَدْخَلَهُ النَّار»([266]).
روى الترمذي بسنده عن يوسف بن إبراهيم أنّه سمع أنس بن مالك يقول:
«سُئِلَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الحسَنُ وَالحسَيْنُ. وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ: ادْعِي لِيَ ابْنَيَّ فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ»([267]).
ومن الفضائل الأخرى للإمامين الحسن والحسين÷ إخبار النبي| بأنّهما سيّدا شباب أهل الجنة، وقد اختصت هذه الفضيلة بهما دون غيرهما، وقد بلغت شهرة الحديث هذا إلى حدّ التواتر، نشير إلى بعضها:
1ـ روى الخطيب البغدادي بسنده عن أمير المؤمنين× أنّ رسول الله| قال:
«الحسَنُ وَالحسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجنَّةِ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا»([268]).
2ـ وروى الحاكم النيسابوري بسنده عن ابن عمر أنّ رسول الله| قال:
«الحسَنُ وَالحسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجنَّةِ، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا»([269]).
3ـ كما روى ابن عساكر بسنده عن ابن عباس عن رسول الله| قوله:
«الحسَنُ وَالحسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجنَّةِ، مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي»([270]).
4ـ وروى بزار بسنده عن أمير المؤمنين علي× أنّ رسول الله| قال مخاطباً فاطمة‘:
«أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الجنَّةِ وَابْنَيْكِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الجنَّةِ»([271]).
نشير هنا إلى بعض الفضائل الخاصة بالإمام الحسين× التي ذكرتها الروايات:
روى الحاكم النيسابوري بسنده عن أبي هريرة أنّه قال:
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ حَامِلٌ الحسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ»([272]).
وروى ابن كثير عن طريق أحمد بن حنبل، وهو بسنده عن أبي سابط أنّه قال: «دَخَلَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ المسْجِدَ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدُ اللهِ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الجنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)»([273]).
روي عن يعلى بن مرة أنّ رسول الله| قال:
«حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْناً»([274]).
وقد صحح الحاكم النيسابوري سند هذا الحديث([275]).
وكتب عنه البويصري في كتابه (مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة):
«هذا إسناد حسن، رجاله ثقات»([276]).
ويرى الهيثمي أيضاً أنّ سند هذا الحديث حسن([277]).
وروى ابن عساكر عن يعلى بن مرة أنّه قال:
«خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَدُعِينَا إِلَى طَعَامٍ، فَإِذَا الحسَيْنُ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ فَأَسْرَعَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَمَامَ الْقَوْمِ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ الحسَيْنُ يَمُرُّ مَرَّةً هَهُنَا وَمَرَّةً هَهُنَا يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ فِي ذَقَنِهِ، وَالْأُخْرَى بَيْنَ رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ اعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّهُ، الحسَنُ وَالحسَيْنُ سِبْطَانِ مِنَ الْأَسْبَاطِ»([278]).
ولنا أن نقول في تفسير جملة «حسين منّي وأنا منه»:
إنّ المقطع الأوّل منها يشير إلى أنّ الحسين× من رسول الله’؛ لأنّه وإن كان ابن الإمام علي× إلّا أنّ علياً× نفس رسول الله| بنص آية المباهلة، وعليه يكون الإمام الحسين× ابن النبي| أيضاً.
وفي المقطع الثاني نقول: إنّ النبي| بعد تبليغه رسالته خرج عن الحالة الشخصية وصار شخصية رسالية، فهو رمز وقدوة تجلّت فيه جميع أبعاد الرسالة، إذن فحياته عين رسالته ورسالته عين حياته.
إضافةً إلى أنّ كل أبٍ يسعى لنيل ولدٍ يخلفه ويحافظ على هويته ورسالته ويكون الامتداد لنهجه وأهدافه. وقد تحقق هذا في الإمام الحسين× حيث أحيى رسالة جدّه المصطفى| بنهضته وشهادته، لذا قال النبي| فيه: «أنا من حسين» أي إنّ بقاء شخصيته الرسالية واستمرارها مرهون بوجود الحسين×، لذلك قيل:
«الإسلام محمّدي الحدوث وحسيني البقاء».
د) أذى النبي| ببكاء الإمام الحسين×
يقول يزيد بن أبي زياد:
«خَرَجَ النَّبِيُّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ، فَمَرَّ عَلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَسَمِعَ حُسَيْناً يَبْكِي، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي؟»([279]).
هـ) الإمام الحسين× محبوب النبي|
روى الحاكم النيسابوري بسنده عن أبي هريرة أنّه قال:
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَهُوَ حَامِلٌ الحسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ»([280]).
إنّ أيّ فردٍ مسلم يؤمن بوصايا الرسول في أهل بيته^ ومنهم الإمام الحسين× لا يشكّ في حجيّة أقوالهم؛ لأنّ الآيات القرآنية والروايات النبوية أكّدت على الأئمة الاثني عشر من بعد رسول الله| وأنّهم من ذريته، وأنّهم يتمتّعون بمقام العصمة والمرجعية الدينية سواء عرف مصدر علومهم أم لم يعرفه. لكن هذا لا يمنع من الإشارة إلى مصادر علوم أهل البيت^ كي لا يظن أحد أنّ حجيّة أقوالهم تعود إلى كونهم أهل بيت النبي| وأنّهم يوحى إليهم كما يوحى إليه.
وقد أشرنا إلى عصمتهم^ في البحث عن حجيّة سنّة الإمام الحسين وأهل البيت^ وأثبتنا مرجعيتهم الدينية من خلال الأدلة القرآنية من قبيل آية (التطهير) ومن خلال بعض الروايات كحديث (الثقلين)، وبناءً على تلك الأدلة تثبت عصمة الإمام الحسين وأهل البيت^ عن جميع الذنوب بل عن الخطأ والسهوٍ والنسيان، وبناءً على ذلك فإنّ كل ما ذكره أهل البيت^ من حقائق قرآنية أو معارف دينية أو بيان للسنّة النبوية فهو عين الواقع غير مشوبٍ بخطأ أو ناشئ عن سهوٍ، لذا يعدّ كلامهم^ من مصادر ومنابع الاستنباط الفقهي، كما هو القرآن والسنّة النبوية. مع ذلك نشير هنا إلى مصادر علوم الإمام الحسين وأهل البيت^:
تعدّ كلمات النبي| وتعاليمه من أهم مصادر علوم أهل البيت^:
1ـ روى الترمذي بسنده عن الإمام علي× أنّه قال:
«كُنْتُ إِذَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَعْطَانِي، وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَأَنِي»([281]).
2ـ وورد عن أم سلمة:
«كَانَ جِبْرِيلُ يَمَلُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ| وَرَسُولُ اللهِ يَمَلُّ عَلَى عَلِيٍّ»([282]).
3ـ كما روى الترمذي عن رسول الله|:
«أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»([283]).
4ـ وقال الإمام علي×:
«عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَلْفَ بَابٍ كُلُّ بَابٍ يَفْتَحُ أَلْفَ بَابٍ»([284]).
5ـ وروى سماعة بن مهران عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«إِنَّ اللهَ عَلَّمَ رَسُولَهُ الحلَالَ وَالحرَامَ وَالتَّأْوِيلَ وَعَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَهُ كُلَّهُ عَلِيّاً×»([285]).
1ـ روى الكليني بسنده عن قتيبة:
«سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ× عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فِيهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا مَا يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ: مَهْ مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ| لَسْنَا مِنْ أَرَأَيْتَ فِي شَيْءٍ»([286]).
2ـ وروى الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر× أنّه قال:
«لَوْ أَنَّا حَدَّثْنَا بِرَأْيِنَا ضَلَلْنَا كَمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَلَكِنَّا حَدَّثْنَا بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّنَا بَيَّنَهَا لِنَبِيِّهِ فَبَيَّنَهَا لَنَا»([287]).
3ـ كما ورد عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي، وَحَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي، وَحَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الحسَيْنِ، وَحَدِيثُ الحسَيْنِ حَدِيثُ الحسَنِ، وَحَدِيثُ الحسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ×، وَحَدِيثُ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ|، وَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ قَوْلُ اللهِ}»([288]).
4ـ وروى الإمام الباقر× عن أبيه عن رسول الله| أنّه قال مخاطباً الإمام علي×:
«اكْتُبْ مَا أُمْلِي عَلَيْكَ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتَخَافُ عَلَيَّ النِّسْيَانَ؟ قَالَ: لَسْتُ أَخَافُ عَلَيْكَ النِّسْيَانَ، وَقَدْ دَعَوْتُ اللهَ لَكَ يُحَفِّظُكَ وَلَا يُنْسِيكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ لِشُرَكَائِكَ. قُلْتُ: وَمَنْ شُرَكَائِي يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِك...»([289]).
1ـ روى محمّد بن مسلم عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق÷:
«إِنَّ عِنْدَنَا صَحِيفَةً مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ أَوْ مُصْحَفِ عَلِيٍّ× طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً، فَنَحْنُ نَتَّبِعُ مَا فِيهَا فَلَا نَعْدُوهَا»([290]).
2ـ كما يقول مروان: سمعت من الإمام الصادق× أنّه قال:
«عِنْدَنَا كِتَابُ عَلِيٍّ× سَبْعُونَ ذِرَاعاً»([291]).
3ـ وروي عن الإمام الصادق× أيضاً أنّه قال:
«وَاللهِ إِنَّ عِنْدَنَا لَصَحِيفَةً طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِيهَا جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ حَتَّى أَرْشُ الخدْشِ، إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ| وَكَتَبَهُ عَلِيٌّ بِيَدِه»([292]).
4ـ يقول سليمان بن خالد: سمعت الإمام الصادق× يقول:
«إِنَّ عِنْدَنَا لَصَحِيفَةً يُقَالُ لَهَا: الجامِعَةُ، مَا مِنْ حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ إِلَّا وَهُوَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الخدْشِ»([293]).
5ـ كما رويعن سليم بن قيس الهلالي أنّه قال:
«شَهِدْتُ وَصِيَّةَ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ× حِينَ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ الحسَنِ× وَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ الحسَيْنَ× وَمُحَمَّداً وَجَمِيعَ وُلْدِهِ وَرُؤَسَاءَ شِيعَتِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ الْكِتَابَ وَالسِّلَاحَ وَقَالَ لِابْنِهِ الحسَنِ×: يَا بُنَيَّ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ| أَنْ أُوصِيَ إِلَيْكَ وَأَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبِي وَسِلَاحِي كَمَا أَوْصَى إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ| وَدَفَعَ إِلَيَّ كُتُبَهُ وَسِلَاحَهُ، وَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَكَ إِذَا حَضَرَكَ الموْتُ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِيكَ الحسَيْنِ×...»([294]).
6ـ قال الإمام الباقر×:
«لَمَّا تَوَجَّهَ الحسَيْنُ× إِلَى الْعِرَاقِ دَفَعَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ| الْوَصِيَّةَ وَالْكُتُبَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَقَالَ لَهَا: إِذَا أَتَاكَ أَكْبَرُ وُلْدِي فَادْفَعِي إِلَيْهِ مَا قَدْ دَفَعْتُ إِلَيْكِ، فَلَمَّا قُتِلَ الحسَيْنُ× أَتَى عَلِيُّ بْنُ الحسَيْنِ× أُمَّ سَلَمَةَ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَاهَا الحسَيْنُ×»([295]).
7ـ وروى الكليني بسنده:
«الْتَفَتَ عَلِيُّ بْنُ الحسَيْنِ× إِلَى وُلْدِهِ وَهُوَ فِي الموْتِ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا الصُّنْدُوقُ اذْهَبْ بِهِ إِلَى بَيْتِكَ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، وَلَكِنْ كَانَ مَمْلُوءاً عِلْماً»([296]).
8ـ وروى زرارة عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«مَا مَضَى أَبُو جَعْفَرٍ حَتَّى صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيّ»([297]).
9ـ وروى النعماني بسنده:
«... قَالَ: ثُمَّ طَلَعَ أَبُو الحسَنِ مُوسَى×، فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ×: أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَاحِبِ كِتَابِ عَلِيٍّ؟ فَقَالَ لَهُ المفَضَّلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يَسُرُّنِي إِذاً أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هُوَ هَذَا صَاحِبُ كِتَابِ عَلِيٍّ الْكِتَابِ المكْنُونِ الَّذِي قَالَ اللهُ}: (ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ)»([298]).
10ـ يقول علي بن يقطين: قال لي الامام أبو الحسن الكاظم×:
«يَا عَلِيُّ، هَذَا أَفْقَهُ وُلْدِي وَقَدْ نَحَلْتُهُ كُتُبِي، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى ابْنِهِ عَلِيٍّ×»([299]).
11ـ قال عبد الملك بن أعين:
«أَرَانِي أَبُو جَعْفَرٍ× بَعْضَ كُتُبِ عَلِيٍّ...»([300]).
12ـ وقال محمّد بن مسلم:
«نَظَرْتُ إِلَى صَحِيفَةٍ يَنْظُرُ فِيهَا أَبُو جَعْفَرٍ× فَقَرَأْتُ فِيهَا مَكْتُوباً: ابْنُ أَخٍ وَجَدٌّ المالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ، فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ×: إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا يَقْضُونَ بِهَذَا الْقَضَاءِ وَلَا يَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الجدِّ شَيْئاً؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ×: أَمَا إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللهِ| وَخَطُّ عَلِيٍّ× مِنْ فِيهِ بِيَدِهِ»([301]).
كانت الكتب الحديثية للإمام علي× شائعةً ومشهورة إلى حدٍّ أصبح أصحاب الصحاح والمسانيد من أهل السنّة يشيرون إلى بعضها:
13ـ أبو جحيفة يقول:
«قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْماً يُعْطِيهِ اللهُ رَجُلاً فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»([302]).
قال الإمام الصادق×:
«... وَلَقَدْ خَلَّفَ رَسُولُ اللهِ| عِنْدَنَا جِلْداً مَا هُوَ جِلْدُ جِمَالٍ وَلَا جِلْدُ ثَوْرٍ وَلَا جِلْدُ بَقَرَةٍ إِلَّا إِهَابَ شَاةٍ فِيهَا كُلَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ حَتَّى أَرْشُ الخدْشِ وَالظُّفُرِ، وَخَلَّفَتْ فَاطِمَةُ مُصْحَفاً مَا هُوَ قُرْآنٌ...»([303]).
5 ـ الإشراقات الإلهية (الإلهام)
من مصادر علوم أهل البيت^ الإشراقات والإلهامات الإلهية التي كانت تفاض على تلك الذوات المقدّسة، الإشراقات التي كانت مفيدة ونافعة لعامّة الناس، وما تلك الإلهامات بالأمر البعيد للغاية، إذ يشير القرآن الكريم والأحاديث الشريفة إلى أمور من هذا القبيل.
1ـ يصف الله تعالى صاحب النبي موسى× بأنّه:
(فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا)([304]).
أشارت الآية الكريمة إلى أحد أولياء الله وليس إلى النبي موسى×، وبيّنت الآية أنّ ذلك العبد الصالح قد وصل إلى درجة من العلم والمعرفة لم يصلها حتّى النبي موسى× الذي يعدّ من أنبياء أولي العزم، لذا أراد موسى× صحبته:
(قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا)([305]).
كان ذلك العبد يتمتّع بعلمٍ لدنيّ وإلهام إلهي.
2ـ يقول الله تعالى في (آصف بن برخيا) صاحب وجليس سليمان النبي×:
(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي) ([306]).
لم يكن ذلك الشخص نبياً قطعاً، لكن بما أنّه لديه علم من الكتاب، ذلك العلم الذي لم يكتسبه من أحد، بل من الإلهام الإلهي والإشراقات الربانية استطاع أن يحضر عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في طرفة عين، ثمّ نسب فعله هذا إلى الله تعالى وقال: (هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي).
تشير الآية الكريمة إلى وجود أفراد غير الأنبياء يتمتّعون بعلوم لدنيّة وإلهامات إلهية اقتضاءً للمهمّة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأهل بيت النبي| بما لهم من عصمة وطهارة وبما أنّهم أولياء الله وأوصياء رسوله كانوا يتمتّعون بهذا النوع من العلم المفاض من قبل الله تعالى على قلوبهم المقدّسة.
3ـ يقول الله تعالى:
(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)([307]).
تدل هذه الآية أيضاً على أنّ هناك بعض الأفراد لديهم علم بكل الكتاب ويتمتّعون بالفيوضات والإشراقات الإلهية.
1ـ روى الشيخ المفيد عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«عِلْمُنَا غَابِرٌ وَمَزْبُورٌ وَنَكْتٌ فِي الْقُلُوبِ وَنَقْرٌ فِي الْأَسْمَاعِ، وَإِنَّ عِنْدَنَا الجفْرَ الْأَحْمَرَ، وَالجفْرَ الْأَبْيَضَ، وَمُصْحَفَ فَاطِمَةَ‘، وَإِنَّ عِنْدَنَا الجامِعَةَ فِيهَا جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ. فَسُئِلَ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْكَلَامِ فَقَالَ: أَمَّا الْغَابِرُ فَالْعِلْمُ بِمَا يَكُونُ، وَأَمَّا المزْبُورُ فَالْعِلْمُ بِمَا كَانَ، وَأَمَّا النَّكْتُ فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ الْإِلهامُ، وَالنَّقْرُ فِي الْأَسْمَاعِ حَدِيثُ الملَائِكَةِ نَسْمَعُ كَلَامَهُمْ وَلَا نَرَى أَشْخَاصَهُم...»([308]).
2ـ كما ورد عن الإمام الصادق×:
«إِنَّ الْإِمَامَ إِذَا شَاءَ أَنْ يَعْلَمَ أُعْلِمَ»([309]).
من المعلوم أنّ النبي| لم تتهيأ له الظروف المناسبة لأجل بيان جميع شريعته بتفاصيلها، فحروب الأعداء من جانب ومحدودية عمره الشريف من جانب آخر حالت دون بيان أحكام الشريعة الإسلامية بجزئياتها، لذا كان من الضروري أن يعيّن خليفةً من بعده يقوم هو الآخر بالاستمرار في إرساء الرسالة السماوية وتطبيق شريعتها الحقّة. فكما كان النبي| بحاجة إلى علم الغيب في الموضوعات الخارجية وموضوعات الأحكام الإلهية ـ التي قمنا بإثباتها في محلها ـ كذلك الإمام والخليفة يحتاج إلى هذا العلم أيضاً.
ورغم أنّ الله تعالى خصّ نفسه بعلم الغيب في بعض آيات القرآن الكريم حيث قال:
(وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ)([310]).
لكنه يشير في آية أخرى إلى تمتّع بعض عباده المرضيين بعلم الغيب أيضاً، حيث يقول:
(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى) ([311]).
كما ترشدنا أحاديث الفريقين إلى أنّ بعض الأفراد يتمتّعون بعلم الغيب كما هو النبي|:
قال الإمام الصادق× لأبي بصير:
«يَا أَبَا بَصِيرٍ، إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ أُوتِينَا عِلْمَ المنَايَا وَالْبَلَايَا وَالْوَصَايَا وَفَصْلَ الْخِطَابِ، وَعَرَفْنَا شِيعَتَنَا كَعِرْفَانِ الرَّجُلِ أَهْلَ بَيْتِهِ»([312]).
1ـ روى مسلم وآخرون عن حذيفة أنّه قال:
«أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ»([313]).
2ـ وروى أحمد بن حنبل بسنده عن أبي إدريس أنّه قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول:
«وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ فِيمَا بَيْنَي وَبَيْنَ السَّاعَةِ»([314]).
3ـ وكتب ابن العماد الحنبلي:
«قال: وكان الشيخ يتكلم يوماً في الإخلاص والرّياء والعجب، وأنا حاضر في المجلس، فخطر في نفسي: كيف الخلاص من العجب؟ فالتفت إليّ الشيخ وقال: إذا رأيت الأشياء من الله تعالى، وأنّه وفقك لعمل الخير، وأخرجت [نفسك] من الشّين، سلمت من العجب»([315]).
ضرورة العمل بروايات الإمام الحسين×
وسنشير هنا باختصار إلى أدلّة ضرورة الأخذ بروايات أهل البيت^ ومن جملتهم الإمام الحسين×:
ذكرت كتب التاريخ والرجال والتراجم من أهل السنّة ما للإمام الحسين× من علمٍ وفضيلةٍ لا تحصى ونقلت عنه أحاديث جمّة، وهذا يكفي في وجوب اتّباع أهل السنّة لرواياته وأحاديثه وإن كانوا لا يعتقدون بإمامته ووصايته من بعد رسول الله|.
1ـ كتب ابن عبد البرّ:
«وكان الحسين فاضلاً ديناً كثير الصيام والصلاة والحج»([316]).
2ـ وقال الشيخ محمّد بن محمّد مخلوف المالكي:
«وأمّا الحسين فكان فاضلاً كثير الصوم والصلاة حجّ خمساً وعشرين حجة ماشياً»([317]).
تمّ البحث في هذا الموضوع بإطنابٍ في محلّه وأثبتنا أنّ الإمام الحسين× وأئمة أهل البيت^ جميعاً يتمتّعون بمقام العصمة، فلا يصدر عنهم الخطأ والنسيان أبداً، لذا كل ما صدر منهم من حديث أو رواية في أيّ بابٍ وعلمٍ كان فإنّه عين الواقع، وحجّة علينا، وهذا ما يوجب على كل مسلمٍ ترك كل سبيل والتمسّك بقناة أهل البيت^ لنيل حقائق القرآن وسنّة النبي الأكرم| فيرجع إليهم للعمل بالأحكام الإلهية التي تضمن له سعادة الدنيا والآخرة.
أكّدت آيات الكتاب العزيز من قبيل (آية التطهير) و(آية أولي الأمر) وغيرها على وجوب الرجوع إلى أهل البيت^ بعد النبي| لأجل الحصول على حقائق القرآن والسنّة النبوية|؛ لأنّ ما يصدر عنهم عين الحقيقة غير مشوب بخطأ أو سهوٍ أو ما شابه.
يقول تعالى:
(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)([318]).
ووفقاً لآية (التطهير)، فإنّ (المطهّرون) هم أهل بيت العصمة والطهارة^.
أمر النبي| جميع المسلمين بالرجوع والتمسّك بالكتاب والعترة إلى يوم القيامة للتعرّف على الدين من خلال هذين الطريقين، وقد وردت عنه أحاديث جمّة من قبيل: (حديث الثقلين)، (حديث السفينة) وغيرها من الأحاديث التي نوقشت بشكلٍ مفصّل في محلها.
هـ) رجوع سنّة الإمام الحسين× إلى السنّة النبوية
بالرجوع إلى روايات أهل البيت^ ومن جملتهم الإمام الحسين× نجد أجمعها ترجع سنداً إلى رسول الله|.
1ـ روى الكليني بسنده عن قتيبة أنّه قال:
«سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ× عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فِيهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ كَذَا وَكَذَا مَا يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهَا؟ فَقَالَ لَهُ: مَهْ مَا أَجَبْتُكَ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ× لَسْنَا مِنْ أَرَأَيْتَ فِي شَيْءٍ»([319]).
2ـ وروى الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر× أنّه قال:
«لَوْ أَنَّا حَدَّثْنَا بِرَأْيِنَا ضَلَلْنَا كَمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَلَكِنَّا حَدَّثْنَا بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّنَا بَيَّنَهَا لِنَبِيِّهِ فَبَيَّنَهَا لَنَا»([320]).
3ـ وروي عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«حَدِيثِي حَدِيثُ أَبِي، وَحَدِيثُ أَبِي حَدِيثُ جَدِّي، وَحَدِيثُ جَدِّي حَدِيثُ الحسَيْنِ، وَحَدِيثُ الحسَيْنِ حَدِيثُ الحسَنِ، وَحَدِيثُ الحسَنِ حَدِيثُ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ×، وَحَدِيثُ أَمِيرِ المؤْمِنِينَ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ|، وَحَدِيثُ رَسُولِ اللهِ قَوْلُ اللهِ}»([321]).
4ـ وروى الإمام الباقر× حديثاً عن آبائه عن رسول الله| قال مخاطباً أمير المؤمنين×:
«اكْتُبْ مَا أُمْلِي عَلَيْكَ. قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتَخَافُ عَلَيَّ النِّسْيَانَ؟ قَالَ: لَسْتُ أَخَافُ عَلَيْكَ النِّسْيَانَ، وَقَدْ دَعَوْتُ اللهَ لَكَ يُحَفِّظُكَ وَلَا يُنْسِيكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ لِشُرَكَائِكَ. قُلْتُ: وَمَنْ شُرَكَائِي يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِك...»([322]).
5ـ وروى المعلّى بن خنيس عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«إِنَّ الْكُتُبَ كَانَتْ عِنْدَ عَلِيٍّ×، فَلَمَّا سَارَ إِلَى الْعِرَاقِ اسْتَوْدَعَ الْكُتُبَ أُمَّ سَلَمَةَ، فَلَمَّا مَضَى عَلِيٌّ كَانَتْ عِنْدَ الحسَنِ، فَلَمَّا مَضَى الحسَنُ كَانَتْ عِنْدَ الحسَيْنِ، فَلَمَّا مَضَى الحسَيْنُ كَانَتْ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الحسَيْنِ، ثُمَّ كَانَتْ عِنْدَ أَبِي»([323]).
6ـ وعن زرارة عن الإمام الصادق× قال:
«مَا مَضَى أَبُو جَعْفَرٍ حَتَّى صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيَّ»([324]).
7ـ كما يقول عبدالملك بن أعين:
«أَرَانِي أَبُو جَعْفَرٍ× بَعْضَ كُتُبِ عَلِيٍّ...»([325]).
8ـ قال الإمام الباقر× لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة:
«شَرِّقَا وَغَرِّبَا لَنْ تَجِدَا عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً يَخْرُجُ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ»([326]).
9ـ قال الإمام الباقر× مخاطباً الحسن البصري:
«فَلْيَذْهَبِ الحسَنُ يَمِيناً وَشِمَالاً فَوَ اللهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَاهُنَا»([327]).
ومقصوده عند أهل البيت^.
10ـ قال يحيى بن عبد الله: كان الإمام الصادق× في جماعة من أهل الكوفة، وكنت عنده وسمعته يقول:
«عَجَباً لِلنَّاسِ أَنَّهُمْ أَخَذُوا عِلْمَهُمْ كُلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ| فَعَمِلُوا بِهِ وَاهْتَدَوْا، وَيَرَوْنَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ لَمْ يَأْخُذُوا عِلْمَهُ! وَنَحْنُ أَهْلُ بَيْتِهِ وَذُرِّيَّتُهُ، فِي مَنَازِلِنَا نَزَلَ الْوَحْيُ، وَمِنْ عِنْدِنَا خَرَجَ الْعِلْمُ إِلَيْهِمْ...»([328]).
عند ملاحظة آيات القرآن الكريم نتوصل إلى أنّ أهل بيت العصمة والطهارة^ قد مسّوا حقيقة كتاب الله ولهم علم كامل بكل تعاليمه، لهذا أصبح كل ما يصدر عنهم من أقوال وأحاديث في شرح وتفسير القرآن حجّة على الجميع. ويمكن إثبات هذا المدّعى من عدّة طرق وأنحاء:
النحو الأوّل ؟؟؟؟؟؟
أ) يقول الله تعالى:
(اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) ([329]).
ب) ولما كان الله معدن النور فلا يصدر منه إلّا النور، يقول الله تعالى:
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا) ([330]).
ج) يقول الله سبحانه:
(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) ([331]).
هناك احتمالان في جملة ﴿لَا يَمَسُّهُ ﴾:
1ـ الجمل ناهية، بمعنى يجب أن لا يمسّ القرآن إلّا الأفراد المطهّرون.
2ـ الجملة نافية، بمعنى أنّ حقيقة القرآن لا يدركها إلّا من اتّصفوا بالطهارة النفسية.
واستعملت كلمة (مسّ) في القرآن الكريم بمعنى المسّ الظاهري والمسّ الباطني أيضاً، وكذا الطهارة فقد استعملت فيه بمعنى الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية.
يقول تعالى في المسّ الظاهري:
(لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً)([332]).
ويقول في المسّ الباطني:
(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ) ([333]).
وجاء في الطهارة الظاهرية:
(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)([334]).
وعن الطهارة الباطنية:
(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ)([335]).
د) ويستفاد من بعض الآيات أنّ أهل بيت العصمة والطهارة^ هم المصداق الواقعي لـ(المطهّرون) الواردة في القرآن:
إذ يقول الله سبحانه:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) ([336]).
يقول الله سبحانه:
(بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) ([337]).
هناك احتمالان في المراد من (العلم) في الآية أعلاه:
وبضم هذه الآية إلى بعض الآيات الأخرى نصل إلى نتيجة، وهذه الآيات:
أ) يقول تعالى:
(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)([338]).
ب) ويقول أيضاً:
(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (77) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)([339]).
ج) ويقول:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) ([340]).
والنتيجة: أنّ الآيات القرآنية محفوظة في صدور أهل البيت^.
وبهذا الاحتمال لو قمنا بضم بعض الآيات يمكننا أن نخرج بنتيجةٍ أيضاً، وهذه الآيات:
أ) آية عصمة الإمام:
يقول تعالى:
(لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) ([341]).
ويقول أيضاً:
(...أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)([342]).
ب) منشأ العصمة هو علم اليقين والعلم بحقائق الأمور:
يقول سبحانه:
(قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ) ([343]).
والنتيجة: أنّ حقيقة القرآن في صدور المعصومين^، ومن كانت حقائق القرآن في صدره فإنّ كل ما يصدر عنه من تفسير أو شرح للقرآن حجّة على المسلمين.
وهذا النحو أيضاً يتمّ من خلال ذكر بعض الآيات التي نصل من خلالها إلى النتيجة المطلوبة:
أ) قال تعالى:
(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) ([344]).
ب) وقال أيضاً:
(إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ * لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)([345]).
ج) وقال:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([346]).
والنتيجة: أنّ الله سبحانه قد أورث علوم القرآن وحقائقه أهل بيت النبي الكرام^.
الدعاء والمناجاة من التراث الثمين ومن الحقائق الفاخرة في الإسلام والقرآن والروايات، حيث يغذي الإنسان روحياً وبدنياً متى ما استفاد منه بالطريقة الصحيحة. وقد وردت الكثير من الأدعية عن المعصومين^ بما فيهم الإمام الحسين× الذي أوردنا أدعيته المباركة في هذه الموسوعة الأمر الذي دعانا إلى شرح مفهوم الدعاء ومصادره ولو بصورة إجمالية.
قال الفيومي حول المفهوم اللغوي للدعاء:
«دعوت الله (أدعوه) (دعاء): ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيما عنده من الخير»([347]).
وأمّا في الاصطلاح فهو عبارة عن طلب العناية والفضل والمعونة من الله تعالى، لذا جاء الحثّ صريحاً على الدعاء في القرآن الكريم والروايات الشريفة.
قال الله تعالى:
(وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) ([348]).
وروي عن أمير المؤمنين× قوله:
«أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ} فِي الْأَرْضِ الدُّعَاءُ»([349]).
تقع الأدعية المنسوبة إلى الإمام الحسين× على أنواع كما يلي:
أ) الأدعية المستقلة:
والمقصود بها تلك الأدعية التي صدرت منه× في مواضع معيّنة أو موضوعات خاصة من قبيل دعاء عرفة و...
ب) الأدعية ضمن الخطب:
والمقصود بها تلك الأدعية التي أوردها الإمام× ضمن خطبه وأحاديثه.
ج) الأدعية العامة:
مثل دعائه× لعموم شيعته وأصحابه.
د) الأدعية الخاصة:
مثل الأدعية التي دعا بها الإمام× لبعض أصحابه.
ﻫ) الأدعية العامة على الأعداء:
من قبيل دعائه× على جيش عمر بن سعد
و) الأدعية الخاصة على الأعداء:
كما جاء في الأدعية على بعض أفراد عسكر عمر بن سعد أو على ابن سعد نفسه([350]).
جاء في كتب الأدعية والحديث جمع من الأدعية المستقلة المنسوبة إلى الإمام الحسين× نشير إلى أهمّها:
يعود سبب تسمية هذا الدعاء بـ(عرفة) إلى المكان الذي قرأ فيه الإمام ذلك الدعاء ألا وهو صعيد عرفات. وقد ورد استحباب قراءة هذا الدعاء يوم عرفة في أيّ مكان كان.
ممن روى هذا الدعاء السيّد ابن طاووس في (إقبال الأعمال)([351]) والكفعمي في (البلد الأمين)([352]) والمجلسي في (بحار الأنوار)([353]) و(زاد المعاد)([354]).
ولهذا الدعاء تتمة اختلف في نسبتها إلى سيّد الشهداء×، فيرى بعضهم أنّ تلك التتمة للإمام الحسين×، ويرى بعض آخر أنّها لابن عطاء الله الإسكندراني من متصوفة أهل السنّة، وسنفصّل الكلام في ذلك.
والظاهر أنّ الإمام الحسين× قرأ هذا الدعاء يوم التاسع من ذي الحجة قبل سنة ستين للهجرة؛ وذلك لأنّ الثامن من ذي الحجة لسنة ستين للهجرة كان الإمام الحسين× قد خرج من مكّة إلى الكوفة.
جاء في كتاب (إقبال الأعمال) في بداية الدعاء:
«وَمِنَ الدَّعَوَاتِ المشَرَّفَةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ دُعَاءُ مَوْلَانَا الحسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ وَلَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ وَهُوَ الجوَادُ الْوَاسِعُ...».
وجاء ذكر هذا الدعاء في (البلد الأمين) بهذا النحو:
«ثُمَّ ادْعُ بِدُعَاءِ الحسَيْنِ× وَهُوَ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ وَلَا كَصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِعٍ وَهُوَ الجوَادُ الْوَاسِعُ...».
وذكر العلامة المجلسي:
«وقال الكفعمي في حاشية البلد الأمين المذكور على أوّل هذا الدعاء: وَذَكَرَ السَّيِّدُ الحسِيبُ النَّسِيبُ رَضِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فِي كِتَابِ مِصْبَاحِ الزَّائِرِ قَالَ: رَوَى بِشْرٌ وَبَشِيرٌ الْأَسَدِيَّانِ أَنَّ الحسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ÷ خَرَجَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَوْمَئِذٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ مُتَذَلِّلاً خَاشِعاً، فَجَعَلَ× يَمْشِي هَوْناً هَوْناً، حَتَّى وَقَفَ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَوُلْدِهِ وَمَوَالِيهِ فِي مَيْسَرَةِ الجبَلِ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ كَاسْتِطْعَامِ الْمِسْكِينِ، ثُمَّ قَالَ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ إِلَى آخِرِهِ»([355]).
والجملة الأخيرة من الدعاء في المقطع الأوّل:
«وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ»([356]).
وجاء في بداية الملحق عبارة:
«إِلَهِي أَنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَايَ فَكَيْفَ لَا أَكُونُ فَقِيراً فِي فَقْرِي»([357]).
وجاء في آخر الملحق عبارة:
«وَالحمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ»([358]).
2 ـ دعاء انتصاف المظلوم على الظالم (دعاء المظلوم)
ونقل هذا الدعاء السيّد ابن طاووس في كتاب (مهج الدعوات)([359])، وذكره الكفعمي في (المصباح)([360]) والمجلسي في (بحار الأنوار)([361]).
وروى السيّد ابن طاووس هذا الدعاء بإسناده عن زرافة حاجب المتوكل عن الإمام الهادي× أنّه قال:
«... رَجَعْتُ إِلَى كُنُوزٍ نَتَوَارَثُهَا مِنْ آبَائِنَا...»([362]).
لكن في بعض الكتب التاريخية والتراجم نسب هذا الدعاء إلى الإمام الحسين×، ويحتمل أنّ هذا الدعاء قد وصل منه إلى الإمام الهادي× فكان يقرأه.
ينقل الميرزا عبد الله الأفندي (متوفى 1130 ﻫ) في كتابه «رياض العلماء» عن حسن بيك روملو (ولد 937 ﻫ) في كتابه (أحسن التواريخ)([363]) في ترجمة (الشيخ علي الكركي):
«وكان من جملة الكرامات التي ظهرت في شأن الشيخ علي أنّ محمود بيك مهردار كان من ألد الخصام وأشدّ الأعداء للشيخ علي، فكان يوماً بتبريز في ميدان صاحبآباد يلاعب بالصولجان بحضرة ذلك السلطان يوم الجمعة وقت العصر، وكان الشيخ علي في ذلك العصر حيث إنّ الدعاء فيه مستجاب يشتغل لدفع شره وفتنته وفساده بالدعاء السيفي ودعاء الانتصاف للمظلوم من الظالم المنسوب إلى الحسين×، ولم يتمّ الدعاء الثاني بعد وكان على لسانه قوله×: «قرب أجله وأيتم ولده» حتّى وقع محمود بيك المذكور عن فرسه في أثناء ملاعبته بالصولجان واضمحل رأسه بعون الله تعالى ـ انتهى ما في تاريخ حسن بيك المذكور ملخصاً»([364]).
وينقل أيضاً السيّد محسن الأمين العاملي (متوفى 1371 ﻫ) في كتابه (أعيان الشيعة)([365]) هذه القصة عن كتاب (رياض العلماء).
وهذا الدعاء رواه السيّد ابن طاووس في (مهج الدعوات)([366])، والمجلسي في (بحار الأنوار)([367]).
وقال السيّد ابن طاووس:
«وَمِنْ ذَلِكَ الرِّوَايَةُ المتَأَخِّرَةُ مِنْ دُعَاءِ الْعَشَرَاتِ وَجَدْنَا إِسْنَادَهَا دُونَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْفَضْلِ وَكَانَ الْقَصْدُ لَفْظَ الدُّعَاءِ مِنْهَا لِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي النَّقْلِ وَهُوَ أَيْضاً مَرْوِيٌّ عَنِ الحسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ÷...»([368]).
وبداية هذا الدعاء بهذا النحو:
«سُبْحَانَ اللهِ وَالحمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ»([369]).
روى هذا الدعاء السيّد ابن طاووس في (جمال الأسبوع)([370]) والمجلسي في (بحار الأنوار)([371]).
وجاء في (جمال الأسبوع) أن يصلي الشخص أربع ركعات قبل قراءة هذا الدعاء، في كل ركعة...([372]).
يبدأ الدعاء بهذا النحو:
«اللَّهُمَّ أَنْتَ الَّذِي اسْتَجَبْتَ لِآدَمَ وَحَوَّاءَ...»([373]).
روى هذا الدعاء كلّ من السيّد ابن طاووس في (مهج الدعوات)([374]) والكفعمي في (المصباح)([375]) والمجلسي في (بحار الأنوار)([376]).
وقال آقابزرگ الطهراني:
«دعاء الاحتجاب منسوب إلى النبي|، وآخر منسوب إلى علي×، وثالث منسوب إلى المجتبى الحسن بن علي÷، ورابع إلى الحسين بن علي÷»([377]).
وبداية الدعاء:
«يَا مَنْ شَأْنُهُ الْكِفَايَةُ وَسُرَادِقُهُ الرِّعَايَةُ، يَا مَنْ هُوَ الْغَايَةُ وَالنِّهَايَةُ...»([378]).
ونقله الشيخ الطوسي في (مصباح المتهجد)([379]) والسيّد ابن طاووس في (إقبال الأعمال)([380]) والكفعمي في (البلد الأمين)([381]) و(المصباح)([382]) والمجلسي في (بحار الأنوار)([383]).
والشيخ الطوسي بعد ذكره هذا الدعاء نقل عن ابن عياش أنّه قال:
«سَمِعْتُ الحسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ سُفْيَانَ الْبَزَوْفَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× يَدْعُو بِهِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»([384]).
وبداية الدعاء هكذا:
«اللَّهُمَّ أنْتَ مُتَعالِي المكانِ...»([385]).
وذكر دعاء آخر أيضاً باسم دعاء (الشدّة)، نقله الشيخ المفيد في (الإرشاد)([386]) عن الإمام الحسين×، أوردناه تحت عنوان (دعاء الفرج) وبدايته هكذا: «يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي...».
هناك أكثر من دعاء حول الاستسقاء وصلنا عن الإمام الحسين×:
الدعاء الأوّل
ذكره الشيخ الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)([387]) وعبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد)([388]).
ويبدأ بالعبارة التالية:
«اللَّهُمَّ مُعْطِيَ الخيْرَاتِ مِنْ مَظَانِّهَا...»([389]).
الدعاء الثاني
ونقل هذا الدعاء ابن قتيبة في (عيون الأخبار)([390]) عن الامام الحسين×. ويبدأ بالقول:
«اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقْياً وَاسِعَةً...».
نقل قطب الدين الراوندي هذا الدعاء في (الدعوات)([391]) عن الإمام الحسين×، يقرأ في اليوم الخامس من كل شهر، وبدايته:
«سُبْحَانَ الرَّفِيعِ الْأَعْلَى سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ...».
ونقله المجلسي أيضاً عن الراوندي في (بحار الأنوار)([392]).
وقد نقل هذا الدعاء السيّد ابن طاووس في (مهج الدعوات)([393]) عن الإمام الحسين×، ويبدأ كالتالي:
«بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَمِنَ اللهِ وَإِلَى اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ...».
ونقله العلامة المجلسي أيضاً في (بحار الأنوار)([394]).
روى هذا الدعاء السيّد ابن طاووس في (مهج الدعوات)([395]) والكفعمي في (المصباح)([396]) عن الإمام الحسين×، وبدايته كالتالي:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الهدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ التَّقْوَى...»([397]).
كما نقله العلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([398]).
وهذا الدعاء رواه كثير من المؤرخين عن الإمام الحسين× بأنّ الإمام× رفع يديه يوم عاشوراء وقرأ هذا الدعاء، وكان مطلعه:
«اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَرَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ...»([399]).
وجاء هذا الدعاء في مصادر، من قبيل:
أ) الطبقات الكبرى، ابن سعد([400]).
ب) تاريخ الأمم والملوك، الطبري([401]).
ج) الإرشاد، الشيخ المفيد([402]).
د) الكامل في التاريخ، ابن الأثير([403]).
ﻫ) سير أعلام النبلاء، الذهبي([404]).
و) البداية والنهاية، ابن كثير([405]).
ز) تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر([406]).
نقل هذا الدعاء الطبرسي في (مكارم الاخلاق)([407])، ويبدأ بالقول:
«الْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ دُودَةٌ تَكُونُ فِي الْفَمِ...».
وأورده المجلسي أيضاً في (بحار الأنوار)([408]).
نقل الخوارزمي هذا الدعاء عن الإمام الحسين× في (مقتل الحسين×)([409]) والحموي في (فرائد السمطين)([410])، وذلك أنّ الإمام× دعا بهذا الدعاء ساجداً وكان قد عفّر وجهه بالتراب:
«سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، أَلِمَقَامِعِ الحدِيدِ خَلَقْتَ أَعْضَائِي...»([411]).
روى السيّد ابن طاووس هذا الدعاء في (مهج الدعوات)([412]) عن الإمام الحسين×، ومطلعه:
«بِسْمِ اللهِ يَا دَائِمُ يَا دَيْمُومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ...».
وذكره المجلسي أيضاً في (بحار الأنوار)([413]).
رواه الشيخ الصدوق في (عيون أخبار الرضا×)([414]) و(كمال الدين)([415]) والكفعمي في (المصباح)([416])، عن الإمام الحسين× أنّ النبي| كان يلقنه وهو يقرأ من بعده.
ومطلع الدعاء:
«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ وَمَعَاقِدِ عَرْشِكَ...»([417]).
ونقله المجلسي أيضاً في (بحار الأنوار)([418]).
نقل الإربلي هذا الدعاء في (كشف الغمّة)([419])، وكان مستهلّه:
«اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الرَّغْبَةِ فِي الْآخِرَةِ...».
وروى ابن بسطام هذا الدعاء عن الإمام الحسين× في (طب الأئمة^)([420]) الذي يبدأه× بقوله:
«بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ...».
كما رواه المجلسي في (بحار الأنوار)([421]).
رواه ابن صباغ المالكي في (الفصول المهمة)([422]) والشبلنجي في (نور الأبصار)([423]) بالتفصيل، والشيخ المفيد في (الإرشاد)([424]) والإربلي في (كشف الغمة)([425]) والطبرسي في (إعلام الورى)([426])، والمجلسي في (بحار الأنوار)([427]) مختصراً.
روي عن الربيع أنّ الإمام الصادق× تلا هذا الدعاء عند دخوله على المنصور فأطفأ غضبه. ويبدأ الدعاء بهذه الصيغة:
«اللَّهُمَّ يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي...»([428]).
وردتنا أدعية عن الإمام الحسين× تقرأ في قنوت الصلوات:
الدعاء الأوّل
نقل السيّد ابن طاووس في (مهج الدعوات)([429]) دعاء عن الإمام الحسين× يبدأ بالعبارة التالية:
«اللَّهُمَّ مِنْكَ الْبَدْءُ وَلَكَ المشِيَّةُ...».
ونقله المجلسي أيضاً في (بحار الأنوار)([430]).
الدعاء الثاني
كما نقل ابن طاووس في نفس الكتاب([431]) دعاءً عن الإمام الحسين× يشرع بهذه العبارة:
«اللَّهُمَّ مَنْ أَوَى إِلَى مَأْوىً فَأَنْتَ مَأْوَايَ...».
نقله المجلسي أيضاً في (بحار الأنوار)([432]) عنه.
ذكر ابن بسطام هذا الدعاء في (طبّ الأئمة)([433])، كما ذكره العلامة المجلسي أيضاً في كتاب (بحار الأنوار)([434])، نقلاً عنه. ويبدأ الدعاء بقوله×:
«بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَإِلَى اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ...».
روى هذا الدعاء العلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([435]) عن الامام الحسين× ونص الدعاء كالتالي:
«اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْفَانِيَةِ وَالْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ أَدْخِلْ عَلَيْهِمْ رَوْحاً مِنْكَ وَسَلَاماً مِنِّي».
روى هذا الدعاء عن الامام الحسين× كلّ من ابن سعد في (الطبقات الكبرى)([436]) وابن أبي شيبة في (المصنف)([437]) والمتقي الهندي في (كنز العمال)([438]).
ونصّ الدعاء:
«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَى وَلَا تُرَى، وَأَنْتَ بِالمنْظَرِ الْأَعْلَى، وَأنَّ إِلَيْكَ الرُّجْعَى، وَأنَّ لَكَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى»([439]).
وقد رواه الحلواني في (نزهة الناظر)([440]) والآبي في (نثر الدرّ)([441])، والإربلي في (كشف الغمة)([442]) والشهيد الأوّل في (الدرة الباهرة)([443]) والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([444]).
ونص الدعاء:
«اللَّهُمَّ لَا تَسْتَدْرِجْنِي بِالْإِحْسَانِ، وَلَا تُؤَدِّبْنِي بِالْبَلَاءِ»([445]).
نقل الزمخشري هذا الدعاء في (ربيع الأبرار)([446]) عن الإمام الحسين×، ونص الدعاء:
«عُبَيْدُكَ بِبَابِكَ، سَائِلُكَ بِبَابِكَ، مِسْكِينُكَ بِبَابِكَ».
ونُقل شبيه هذا الدعاء أيضاً عن الإمام السجاد×([447]) والإمام المهدي#([448]).
وهو الدعاء الذي رواه القندوزي الحنفي في كتابه (ينابيع المودة)([449]) عن الإمام الحسين× وأنّه تلاه يوم عاشوراء.
«يَا إِلَهِي صَبْراً عَلَى قَضَائِكَ وَلَا مَعْبُودَ سِوَاكَ يَا غِيَاثَ المسْتَغِيثِينَ».
هناك بعض الأدعية التي تلاها الإمام× في بداية خطبته أو في وسطها أو آخرها، ومنها:
وقد أورد هذا الدعاء كلّ من الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)([450])، والشيخ المفيد في كتاب (الإرشاد)([451])، والفتال النيسابوري في (روضة الواعظين)([452]) والطبرسي في كتاب (إعلام الورى)([453]) والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([454]).
وما نقله الشيخ المفيد كان كالتالي:
«فَجَمَعَ الحسَيْنُ× أَصْحَابَهُ عِنْدَ قُرْبِ المسَاءِ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الحسَيْنِ زَيْنُ الْعَابِدِينَ×: فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِأَسْمَعَ مَا يَقُولُ لَهُمْ وَأَنَا إِذْ ذَاكَ مَرِيضٌ فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: أُثْنِي عَلَى اللهِ أَحْسَنَ الثَّنَاءِ وَأَحْمَدُهُ عَلَى السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ عَلَى أَنْ أَكْرَمْتَنَا بِالنُّبُوَّةِ وَعَلَّمْتَنَا الْقُرْآنَ وَفَقَّهْتَنَا فِي الدِّينِ وَجَعَلْتَ لَنَا أَسْمَاعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَاجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ...»([455]).
وجاء هذا الدعاء ضمن خطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكره ابن شعبة الحراني في (تحف العقول)([456]) والعلامة المجلسي أيضاً عنه في (بحار الأنوار)([457]).
وعبارات الدعاء:
«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَافُساً فِي سُلْطَانٍ، وَلَا الْتِمَاساً مِنْ فُضُولِ الحطَامِ، وَلَكِنْ لِنُرِيَ المعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، وَيَأْمَنَ المظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَنِكَ وَأَحْكَامِكَ، فَإِنْ لَمْ تَنْصُرُونَا وَتُنْصِفُونَا قَوِيَ الظَّلَمَةُ عَلَيْكُمْ، وَعَمِلُوا فِي إِطْفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمْ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا وَإِلَيْهِ المصِيرُ».
وردت بعض الأدعية العامة عن سيّد الشهداء× في حق الشيعة والموالين، نشير إلى بعضها:
تلا الإمام× هذا الدعاء في مسيره إلى كربلاء عند سماعه خبر مقتل قيس بن مسهر الصيداوي بيد عبيد الله بن زياد:
جاء ذكر هذا الدعاء في مصادر من قبيل:
أ) (تاريخ الأمم والملوك)، الطبري([458]).
ب) (الفتوح)، ابن أعثم([459]).
ج) (مقتل الحسين×)، الخوارزمي([460]).
د) (مثير الأحزان)، ابن نما([461]).
ﻫ) (اللهوف)، السيّد ابن طاووس([462]).
و) (الكامل في التاريخ)، ابن الأثير([463]).
ز) (تسلية المجالس وزينة المجالس)، الحائري الكركي([464]).
ح) (بحار الأنوار)، العلامة المجلسي([465]).
وجاء نصّ الدعاء:
«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا وَلِشِيعَتِكَ مَنْزِلاً كَرِيماً عِنْدَكَ، وَاجْمَعْ بَيْنَنَا وَإِيَّاهُمْ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»([466]).
نقل هذا الدعاء عن الإمام الحسين× كلّ من: ابن أعثم في (الفتوح)([467]) والخوارزمي الحنفي في (مقتل الحسين×)([468]) والحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([469]) وقد جاء في جواب رسالتين من أهل الكوفة.
نصّ الدعاء:
«جَمَعَنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ عَلَى الهدَى، وَأَلْـزَمَنَا وَإِيَّاكُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، إِنَّهُ لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ»([470]).
والمقصود بها ما دعا به سيّد الشهداء× في حق بعض أصحابه. نشير إلى بعضها:
1 ـ دعاؤه في حق جون بن حوي النوبي
نقل هذا الدعاء الحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([471])، والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([472]) عن الإمام الحسين× حيث دعا به في لحظات استشهاد جون.
والدعاء هو:
«اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهَهُ، وَطَيِّبْ رِيحَهُ، وَاحْشُرْهُ مَعَ الْـأَبْرَارِ، وَعَرِّفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ»([473]).
قام بنقل هذا الدعاء الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)([474]) والحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([475])، والعلامة المجلسي في (بحارالأنوار)([476]) وهو الدعاء الذي دعا به× بحقّ سيف بن الحارث ومالك بن عبد. ونص الدعاء:
«جَزَاكُمَا اللهُ يَا ابْنَيْ أَخِي بِوُجْدِكُمَا مِنْ ذَلِكَ وَمُوَاسَاتِكُمَا إِيَّايَ بِأَنْفُسِكُمَا أَحْسَنَ جَزَاءِ المتَّقِينَ»([477]).
ممن روى هذا الدعاء الطبري في كتابه (تاريخ الأمم والملوك)([478])، وابن الأثير في (الكامل في التاريخ)([479])، وابن نما في (مثير الأحزان)([480])، وابن طاووس في (اللهوف)([481])، والحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([482])، والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([483]) وكان الإمام الحسين× قد تلاه عندما خرجت أم وهب من الخيمة لتقاتل أعداء الله، فدعا قائلاً:
«جُزِيتُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ خَيْراً، ارْجِعِي رَحِمَكِ اللهُ إِلَى النِّسَاءِ»([484]).
4 ـ دعاؤه في حقّ يزيد بن مسعود النهشلي
روى هذا الدعاء ابن نما في (مثير الأحزان)([485])، والسيّد ابن طاووس في كتابه (اللهوف)([486])، والحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([487])، والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([488]) حيث دعا الإمام به ليزيد النهشلي والذي كان من أشراف البصرة وأصحابه×.
نص الدعاء:
«آمَنَكَ اللهُ يَوْمَ الخوْفِ أَعَزَّكَ وَأَرْوَاكَ يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرِ»([489]).
5 ـ دعاؤه في حقّ أبي ثمامة الصائدي
روي هذا الدعاء عن الإمام الحسين× في عدّة كتب من قبيل: (تاريخ الأمم والملوك)([490]) للطبري، و(الكامل في التاريخ)([491]) حيث قال× في حق أبي ثمامة عمرو ابن عبد الله الصائدي لما ذكّر الإمام بالصلاة عندما حان وقتها.
والدعاء كالآتي:
«جَعَلَكَ اللهُ مِنَ المصَلِّينَ الذَّاكِرِينَ»([492]).
6 ـ دعاؤه في حق أبي الشعثاء الكندي
هذا الدعاء من بين الأدعية التي رواها الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)([493])، والخوارزمي الحنفي في (مقتل الحسين×)([494])، وابن الأثير في (الكامل في التاريخ)([495])، والحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([496])، والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([497]) عن الامام الحسين× وكان في حق أبي الشعثاء الكندي، عندما ثنى ركبتيه بين يدي الإمام×، ورمى بمائة سهم نحو الأعداء، والإمام يدعو ويقول:
«اللَّهُمَّ سَدِّدْ رَمْيَتَهُ، وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الجنَّةَ»([498]).
هناك جمع من أدعية الإمام الحسين× على أعدائه بصورة عامة، وربما بلغ بعضها درجة اللعن. نشير إلى بعضها أدناه:
1 ـ ما دعا به× بعدما أصاب السهم ولده الرضيع
نقل هذا الدعاء جمع من العلماء والمؤرخين أمثال الطبري في (تاريخ الأمم والملوك)([499]) والشيخ المفيد (الإرشاد)([500]) والطبرسي في (إعلام الورى)([501]) وابن نما في (مثير الأحزان)([502]) والشامي في (الدر النظيم)([503]) وابن الأثير في (الكامل في التاريخ)([504]) والحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([505]) والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([506]) وذلك حينما وقع السهم في نحر ولده الرضيع، وجاء فيه:
«رَبِّ إِنْ تَكُنْ حَبَسْتَ عَنَّا النَّصْرَ مِنَ السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ، وَانْتَقِمْ لَنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ»([507]).
2 ـ ما دعا به× عندما ضُرب القاسم×
روي هذا الدعاء عن الإمام الحسين× من قبل الخوارزمي الحنفي في (مقتل الحسين×)([508]) والحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([509])، والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([510]) وذلك عندما سقط القاسم من على ظهر جواده، ووقف الإمام على رأسه فدعا على جيش عمر بن سعد بقوله:
«اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً، وَاقْتُلْهُمْ بَدَداً، وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً، وَلَا تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَداً»([511]).
3 ـ ما دعا به الإمام× حين خروج علي الأكبر× للمعركة
وروى ذلك عن الإمام الحسين× كلّ من ابن أعثم في كتاب (الفتوح)([512]) والخوارزمي الحنفي في كتاب (مقتل الحسين×)([513]) والحائري الكركي في كتاب (تسلية المجالس وزينة المجالس)([514]) والعلامة المجلسي في كتاب (بحار الأنوار)([515]) وذلك حينما برز ولده علي الأكبر× يوم عاشوراء فدعا الإمام على جيش عمر بن سعد بقوله:
«اللَّهُمَّ اشْهَدْ عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَقَدْ بَرَزَ إِلَيْهِمْ غُلَامٌ أَشْبَهُ النَّاسِ خَلْقاً وَخُلُقاً وَمَنْطِقاً بِرَسُولِكَ|، كُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَى نَبِيِّكَ| نَظَرْنَا إِلَى وَجْهِهِ، اللَّهُمَّ امْنَعْهُمْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، وَفَرِّقْهُمْ تَفْرِيقاً، وَمَزِّقْهُمْ تَمْزِيقاً، وَاجْعَلْهُمْ طَرَائِقَ قِدَداً، وَلَا تُرْضِ الْوُلَاةَ عَنْهُمْ أَبَداً، فَإِنَّهُمْ دَعَوْنَا لِيَنْصُرُونَا، ثُمَّ عَدَوْا عَلَيْنَا يُقَاتِلُونَنَا»([516]).
4 ـ ما دعا به× بعد نصيحته لمعسكر الأعداء
روى هذا الدعاء كلّ من السيّد ابن طاووس في كتاب (اللهوف)([517]) والحائري الكركي في كتاب (تسلية المجالس وزينة المجالس)([518]) والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([519]) من أنّ الإمام بعدما فرغ من النصح لجيش عمر بن سعد يوم عاشوراء دعا عليهم بهذا الدعاء:
«اللَّهُمَّ احْبِسْ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ، وَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، وَسَلِّطْ عَلَيْهِمْ غُلَامَ ثَقِيفٍ يَسْقِيهِمْ كَأْساً مُصَبَّرَةً، وَلَا يَدَعُ فِيهِمْ أَحَداً إِلَّا قَتَلَهُ قَتْلَةً بِقَتْلَةٍ، وَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، يَنْتَقِمُ لِي وَلِأَوْلِيَائِي وَأَهْلِ بَيْتِي وَأَشْيَاعِي مِنْهُمْ، فَإِنَّهُمْ غَرُّونَا وَكَذَبُونَا وَخَذَلُونَا، وَأَنْتَ رَبُّنَا، عَلَيْكَ تَوَكَّلْنا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنا، وَإِلَيْكَ المصِيرُ»([520]).
5 ـ ما دعا به× حين شهادة علي الأكبر×
نُقل عن الإمام الحسين× دعاؤه هذا على الأعداء لما ضُرب ولده على الأكبر، ونصه:
«قَتَلَ اللهُ قَوْماً قَتَلُوكَ، فَمَا أَجْرَأَهُمْ عَلَى اللهِ وَعَلَى انْتِهَاكِ حُرْمَةِ الرَّسُولِ»([521]).
وقد ذكر في المصادر التالية:
أ) تاريخ الأمم والملوك، الطبري([522]).
ب) الإرشاد، الشيخ المفيد([523]).
ج) إعلام الورى، الطبرسي([524]).
د) مقتل الحسين×، الخوارزمي الحنفي([525]).
ﻫ) مثير الأحزان، ابن نما([526]).
و) اللهوف، السيّد ابن طاووس([527]).
ز) الدر النظيم، الشامي([528]).
ح) الكامل في التاريخ، ابن الأثير([529]).
ط) البداية والنهاية، ابن كثير([530]).
ي) تسلية المجالس وزينة المجالس، الحائري الكركي([531]).
ك) بحار الأنوار، العلامة المجلسي([532]).
6 ـ ما دعا به الإمام× بعد إصابته بسهم في جبهته
لما وقع السهم في جبهة الإمام× دعا على عسكر عمر بن سعد بهذا الدعاء. وقد رواه ابن أعثم في (الفتوح)([533]) والخوارزمي الحنفي في (مقتل الحسين×)([534]) والحائري الكركي في كتاب (تسلية المجالس وزينة المجالس)([535]) والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([536]) ونصّه:
«اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَداً، وَاقْتُلْهُمْ بَدَداً، وَلَا تَذَرْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَداً، وَلَا تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَداً»([537]).
وأمّا بخصوص من يشملهم هذا الدعاء فهناك ثلاثة احتمالات:
1ـ يشمل خصوص معسكر عمر بن سعد.
2ـ يشمل معسكر ابن سعد وكل من رضي بفعلهم في ذلك الزمن أو بعده.
3ـ يشمل معسكر ابن سعد ونسلهم مطلقاً حتّى يوم القيامة.
إنّ من يتأمّل في هذه الأدعية ويعتقد بالعدل الإلهي يدرك أنّها كانت على نحو القضية الخارجية وأنّها تختص بمعسكر عمر بن سعد أو من رضي بفعلهم ـ بقرينة ما ورد في بعض الروايات ـ سواء كانوا في ذلك الزمن أو ظهروا بعده، لذا فإنّ حمل هذه الأدعية على نحو القضية الحقيقية بحيث يشمل جميع الأجيال إلى يوم القيامة خلاف ظاهر الأدعية والأصول العقائدية للدين الإسلامي.
روى الشيخ الصدوق في كتاب (عيون أخبار الرضا×) بسنده عن عبد السلام بن صالح الهروي بأنّه سأل الإمام الرضا×:
«يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ لِأَيِّ عِلَّةٍ أَغْرَقَ اللهُ الدُّنْيَا كُلَّهَا فِي زَمَنِ نُوحٍ×، وَفِيهِمُ الْأَطْفَالُ وَفِيهِمْ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ فِيهِمُ الْأَطْفَالُ؛ لِأَنَّ اللهَ} أَعْقَمَ أَصْلَابَ قَوْمِ نُوحٍ وَأَرْحَامَ نِسَائِهِمْ أَرْبَعِينَ عَاماً، فَانْقَطَعَ نَسْلُهُمْ، فَغَرِقُوا وَلَا طِفْلَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللهُ} لِيَهْلِكَ بِعَذَابِهِ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. وَأَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَأُغْرِقُوا لِتَكْذِيبِهِمْ لِنَبِيِّ اللهِ نُوحٍ×، وَسَائِرُهُمْ أُغْرِقُوا بِرِضَاهُمْ بِتَكْذِيبِ المكَذِّبِينَ، وَمَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَ بِهِ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ وَأَتَاهُ»([538]).
الأدعية الخاصة على الأعداء
والمقصود منها الأدعية التي دعا بها الإمام× على بعض الأفراد، بما فيها:
1 ـ ما دعا به× على جنازة المنافق
دعا الإمام الحسين×
بهذا الدعاء حين صلاته على جنازة منافق. رواه الحميري في (قرب الإسناد)([539])
والكليني في (الكافي)([540])
والشيخ الصدوق في
(من لا يحضره الفقيه)([541])
والشيخ الطوسي في (تهذيب الأحكام)([542])
والشيخ الحر العاملي في (وسائل الشيعة)([543])
والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([544])
ونص الدعاء:
«اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً عَبْدَكَ أَلْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ، اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَبِلَادِكَ، وَأَصْلِهِ حَرَّ نَارِكَ، وَأَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ، وَيُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ، وَيُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ|»([545]).
للإمام× دعاء على عمر بن سعد حينما توجه ولده وفلذة كبده علي الأكبر إلى المعركة، ورواه ابن أعثم في (الفتوح) ([546]) والخوارزمي الحنفي في (مقتل الحسين×)([547]) والحائري الكركي في (تسلية المجالس وزينة المجالس)([548]) والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([549]).فخاطب عمر بن سعد قائلاً:
«قَطَعَ اللهُ رَحِمَكَ، وَلَا بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَمْرِكَ، وَسَلَّطَ عَلَيْكَ مَنْ يَذْبَحُكَ بَعْدِي عَلَى فِرَاشِكَ، كَمَا قَطَعْتَ رَحِمِي، وَلَمْ تَحْفَظْ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ|»([550]).
لقد دعا الإمام على ابن حوزة بالنار خلال حوار جرى بينهما أثناء المعركة، ورواه عنه× ابن شهرآشوب في (مناقب آل أبي طالب)([551])، والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([552])، ونصّ الدعاء:
«اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ كَاذِباً فَجُرَّهُ إِلَى النَّار»([553]).
وبناء على رواية أخرى قال:
«اللَّهُمَّ جُرَّهُ إِلَى النَّارِ وَأَذِقْهُ حَرَّهَا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ مَصِيرِهِ إِلَى الْآخِرَةِ»([554]).
4 ـ دعاؤه× على محمّد بن الأشعث
وروى ذلك كلّ من الشيخ الصدوق في (الأمالي)([555]) وابن شهرآشوب في (مناقب آل أبي طالب)([556]) والخوارزمي الحنفي في (مقتل الحسين×)([557]) والفتال النيسابوري في (روضة الواعظين)([558]) والعلامة المجلسي في (بحار الأنوار)([559]) بأنّ الإمام الحسين× دعاء عليه يوم عاشوراء بقوله:
«اللَّهُمَّ أَرِ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذُلّاً فِي هَذَا الْيَوْمِ، لَا تُعِزُّهُ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَداً»([560]).
نعم، إنّ كلّ من يطالع صفحات التاريخ ويتأمّل فيها يجد أنّ أدعية الإمام× كانت تستجاب وتتحقق على أرض الواقع سواءً في حينها أو بعد مدّة من الزمن، فكان من بينها ما انطوى على الإعجاز في تحققه في الحال كما في بعض الأدعية الخاصة على أفراد معينين، ومنها ما استجيب وتحقق بعد مرور فترة من الزمن كما في حقّ جيش عمر بن سعد والراضين بفعلهم القبيح.
أجل، قد يكون فعل العدو إلى درجة من الشناعة بحيث يستجاب دعاء ولي الله في الحال فيهلك العدو، كما تحقق ذلك في بعض الأرجاس يوم عاشوراء.
أبرز خصائص أدعية الإمام الحسين×
وكما تقدّم ذكره أنّ الإمام الحسين× كغيره من الأئمة^ روي عنه الكثير من الأدعية بنحو الخصوص أو العموم، وحال الأدعية حال الروايات والآيات القرآنية في كونها يفسر بعضها بعضاً، لكن بما أنّ الدعاء يتأثر بما يحيط به من ظروف وأحوال، وأغلب تلك الأدعية صدرت من الإمام× في حالات ومواقف خاصة جدّاً، لذا تتمتّع بشيء من الشعور الخاص الذي يندر مشاهدته في أدعية غيره من المعصومين^.
هذه الأحاسيس والانفعالات الروحية يمكن ملاحظتها في خطبه× وأدعيته؛ لأنّ أغلب تلك الخطب ألقاها عند نهضته وإعلان ثورته على يزيد بن معاوية، خاصة في الأيام القريبة من استشهاده× حيث كان يعيش ظروفاً روحيةً خاصة، أو في يوم عاشوراء الذي له عظمته، لذا فإنّ أدعيته× امتازت بخصائص فريدة أهمّها بثّ روح الثورة ونيل الشهادة في القارئ، وسوقه نحو المعرفة الروحية الداعية للفناء في الله.
دراسة حول تتمة دعاء الإمام الحسين× يوم عرفة
يعدّ دعاء عرفة وتتمته من المصادر المهمّة للموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×، لكن هناك اختلاف في انتساب تتمة الدعاء إلى الإمام الحسين×، لذا ارتأينا أن ندرس هذه المسألة في مدخل الموسوعة ولو بصورة مختصرة كما فعل المحدّث النوري في خاتمة (مستدرك الوسائل) حيث عقد بحثاً في صحة انتساب مصادره التي اعتمد عليها.
لم يرد ذكر هذا الدعاء في كتب الأدعية والروايات التي وصلتنا قبل القرن السابع.
ومصادر هذا الدعاء عبارة عن:
يُعتبر كتاب (إقبال الأعمال)([561]) للسيّد علي بن طاووس (589 ـ 664 ق) المصدر الرئيس لهذا الدعاء في الوقت الحاضر، حيث قد أفرد المؤلف في هذا الكتاب فصلاً لبيان الأدعية التي يستحب قراءتها في يوم عرفة، وقال ضمن ذلك:
«وَمِنَ الدَّعَوَاتِ المشَرَّفَةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ دُعَاءُ مَوْلَانَا الحسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ...»([562]).
ثمّ استمر بنقل الدعاء دون إشارةٍ إلى سنده أو مصدره أو رواته، لا في أوّل الدعاء ولا في وسطه ولا آخره، ثمّ أرفده بدعاءٍ آخرٍ ذي مضامين راقية وعميقة تستهله هذه العبارات:
«إِلَهِي أَنَا الْـفَقِيرُ فِي غِنَايَ فَكَيْفَ لَا أَكُونُ فَقِيراً فِي فَقْرِي»([563]).
وينتهي بهذه العبارات:
«كَيْفَ تَخْفَى وَأَنْتَ الظَّاهِرُ أَمْ كَيْفَ تَغِيبُ وَأَنْتَ الرَّقِيبُ الحاضِرُ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَالحمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ»([564]).
لكن لم تذكر تتمة دعاء عرفة فيه، لا في النسخة الخطية ولا في الطبعة الحالية التي قامت بنشرها (مؤسسة آل البيت^).
قال العلامة المجلسي:
«وقال الكفعمي في حاشية البلد الأمين المذكور على أوّل هذا الدعاء: وَذَكَرَ السَّيِّدُ الحسِيبُ النَّسِيبُ رَضِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ فِي كِتَابِ مِصْبَاحِ الزَّائِرِ قَالَ: رَوَى بِشْرٌ وَبَشِيرٌ الْأَسَدِيَّانِ أَنَّ الحسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ÷ خَرَجَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ يَوْمَئِذٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ مُتَذَلِّلاً خَاشِعاً، فَجَعَلَ× يَمْشِي هَوْناً هَوْناً، حَتَّى وَقَفَ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَوُلْدِهِ وَمَوَالِيهِ فِي مَيْسَرَةِ الجبَلِ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ كَاسْتِطْعَامِ الْمِسْكِينِ، ثُمَّ قَالَ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ إِلَى آخِرِهِ»([565]).
وقال العلّامة المجلسي فيما بعد:
«صبا (مصباح الزائر)، في بحث زيارة يوم عرفة روى بشر وبشير الأسديان وساق على نحو ما نقلناه عن حاشية (البلد الأمين)، ثمّ أورد هذا الدعاء على نحو ما في (البلد الأمين)»([566]).
وقال المحدّث النوري:
«وَفِي مِصْبَاحِ الزَّائِرِ: عَنْ بِشْرٍ وَبَشِيرٍ ـ فِي الخبَرِ المتَقَدِّمِ ـ قَالا: ثُمَّ دَعَا× فَقَالَ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ ـ إِلَى أَنْ قَالا ـ ثُمَّ إِنَّهُ× انْدَفَعَ فِي المسْأَلَةِ، وَاجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ وَعَيْنَاهُ تَقْطُرَانِ دُمُوعاً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ ـ إِلَى أَنْ قَالا ـ ثُمَّ رَفَعَ× صَوْتَهُ وَبَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَيْنَاهُ قَاطِرَتَانِ كَأَنَّهُمَا مَزَادَتَانِ، وَقَالَ× بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ ـ الدُّعَاءَ إِلَى قَوْلِهِ ـ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ»([567]).
كما نقل تقي الدين إبراهيم بن علي الكفعمي (840 ـ 905 ق) هذا الدعاء في كتابه (البلد الأمين)([568]) مع وجود اختلاف قليل مقارنةً لما نقله السيّد ابن طاووس في كتابه (مصباح الزائر).
وكتب المحدث النوري في تتمة العبارة السابقة:
«وَرَوَاهُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: قَالَ بِشْرٌ وَبَشِيرٌ: فَلَمْ يَكُنْ لَهُ جُهْدٌ إِلَّا قَوْلُهُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ بَعْدَ هَذَا الدُّعَاءِ، وَشَغَلَ مَنْ حَضَرَ مِمَّنْ كَانَ حَوْلَهُ، وَشَهِدَ ذَلِكَ المحْضَرَ عَنِ الدُّعَاءِ لِأَنْفُسِهِمْ، وَأَقْبَلُوا عَلَى الِاسْتِمَاعِ لَهُ، وَالتَّأْمِينِ عَلَى دُعَائِهِ قَدِ اقْتَصَرُوا عَلَى ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْبُكَاءِ مَعَهُ، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَأَفَاضَ×، وَأَفَاضَ النَّاسُ مَعَهُ»([569]).
وجاءت بداية الدعاء في كتاب (البلد الأمين) للكفعمي مشابهةً لكتاب (الإقبال)، لكنها خالية أيضاً عن ذكر مصدر الدعاء وأسماء الرواة. وأورد المؤلف الدعاء ضمن أعمال يوم عرفة قائلاً:
«ثُمَّ ادْعُ بِدُعَاءِ الحسَيْنِ× وَهُوَ: الحمْدُ لِلهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ...»([570]).
نقل العلامة المجلسي (1037 ـ 1110 ق) هذا الدعاء في كتاب (زاد المعاد)([571]) كالكفعمي، لكنه نقله في (بحار الأنوار) عن كتاب (إقبال الأعمال)، ثمّ أتبعه بتوضيح سنذكره لاحقاً.
وأمّا الشيخ عباس القمي (1294 ـ 1359 ق) فقد نقل هذا الدعاء في كتاب (مفاتيح الجنان)([572]) عن الكفعمي، ونقل المقطع الأخير من الدعاء على أنّه إضافة من كتاب الإقبال للسيّد ابن طاووس.
أشكل حامد خاني في مقالته المعنونة بـ(الدفاع عن أصالة أدعية أهل البيت^) قائلاً:
«والإبهام الآخر يعود إلى أنّ ابن طاووس لم يذكر أيّ واسطة بينه وبين الرواة الأوائل للدعاء. لا شك بأنّ ابن طاووس من أبرز محدثي الشيعة ومن أكابر العلماء العارفين للغة الدعاء في العالم الإسلامي، لكن هذا لا يعني أنّ ما بين يديه من المصادر يجب أن تكون من أصحّ المصادر وأتقنها في النقل، كما أنّ ذلك ليس ببعيد، فلربما يقع أحياناً ـ كما احتمل المجلسي ذلك ـ أن تتلاعب بعض الأيادي بمرور الزمان بآثار ابن طاووس تحريفاً وتصحيفاً ونحوهما.
فمن جانب إنّ أقدم مصدر يحتوي على أثر ابن طاووس يعدّ مصدراً متأخراً، ومن جانب آخر فإنّه ليس من المعلوم أنّ نصّ الدعاء كان عند من في تلك الفترة، وكيف وصل لابن طاووس؟ وهل طرأ عليه ثمة تغيير وتحوّل خلال سيره التاريخي؟ للدفاع عن أصالة دعاء عرفة لا بدّ من العثور على طريقة تثبت أنّ هذا الدعاء وإن وصلنا عن طريق مصدر متأخر إلّا أنّه ليس نصاً مختلقاً في العهود المتأخرة أبداً، بل الشواهد المختلفة تؤيد أنّه يعود إلى عصر أهل البيت^.
إضافة إلى أنّ معرفتنا بأقدم السامعين والكاتبين لهذا الدعاء محدودة جدّاً لا تتعدّى اسمين لا غيرهما: بشر وبشير، وما يذكره علماء الرجال عنهما مجرّد معلومات يسيرة وكأنّه لم يسمع أحد هذا الدعاء من الإمام غيرهما، ثمّ لم يرويا ذلك الحديث لأحد بعد سماعه. قد يحدث مثل هذا الموقف أحياناً، لكن مع ذلك يبقى هذا الحدث غريباً وبحاجة إلى دقة وتأمّل؛ لأنّنا لم نعثر على اسم سوى هذين الراويين، ولا نعلم شيئاً عن رواة دعاء عرفة في الفترة التي سبقت ابن طاووس»([573]).
أوّلاً: إنّ شأن السيّد ابن طاووس أجلّ من أن ينسب له التساهل في نقل الحديث والدعاء.
ثانياً: أين ذلك الموضع الذي نسب فيه العلامة المجلسي التحريف والتصحيف إلى آثار السيّد ابن طاووس؟
ثالثاً: كيف عدّ بشر وبشير مجهولين في حين فصّل في الحديث عنهما.
رابعاً: من الأساليب التي يمكن من خلالها تحصيل سند رواية مرسلة، الرجوع إلى طرق الراوي التي ينقل بها رواياته.
وبما أنّ السيّد ابن طاووس نقل في كتاب (الإقبال) مطالب كثيرة من كتاب (عمل ذي الحجة) لـ(أبي علي الحسن بن محمّد بن إسماعيل بن محمّد أشناس) ونقل عنه الكثير من الأدعية أيضاً حتّى عدّ من رواة الصحيفة السجادية، فليس ببعيد أن يكون قد روى دعاء عرفة أيضاً، ونقله السيّد ابن طاووس عنه من كتاب (عمل ذي الحجة).
وكتب السيّد ابن طاووس ضمن بحثه لفضل العشرة الأولى من ذي الحجة:
«وجدنا ذلك في كتاب عمل ذي الحجة تأليف أبي علي الحسن بن محمّد بن إسماعيل بن محمّد بن أشناس البزاز من نسخة عتيقة بخطه، تاريخها سنة سبع وثلاثين وأربعمائة، وهو من مصنفي أصحابنا+، بإسناده إلى رسول الله| أنّه قال:...»([574]).
إن صحّت هذه الفرضية وهي أنّ السيّد ابن طاووس قد نقل دعاء عرفة من كتاب (عمل ذي الحجة)، فهي شهادة على أنّ هذا الكتاب عند السيّد بخط المؤلف نفسه وهي كافية في اعتباره، وهذا يغنينا عن دراسة طريق السيّد إلى هذا الكتاب، إذ لا يمكن للسيّد بورعه وتقواه أن يشهد بهذه الصورة دون أن تكون بيده قرائن وشواهد قطعية على ذلك.
ويبدو أنّ خطّ الحسن بن أشناس كان معروفاً، بدليل قول ابن إدريس الحلي في ترجمته لإسماعيل بن أبي زياد السكوني:
«...وله كتاب يعدّ في الأصول، وهو عندي بخطي كتبته من خط ابن أشناس البزاز وقد قرئ على شيخنا أبي جعفر...»([575]).
والحسن بن أشناس من أساتذة الشيخ الطوسي (المتوفى 460) ومن تلامذة الشيخ المفيد (المتوفى 413)، وهو الذي كتب عنه الحر العاملي:
«كان عالما فاضلاً، وثقه السيّد علي بن طاوس في بعض مؤلفاته»([576]).
وأرّخ الخطيب البغدادي تاريخ ولادته في 359 ووفاته في 439 ق. وقال عنه:
«وكان له مجلس في داره بالكرخ يحضره الشيعة...»([577]).
يستفاد من كلام الخطيب البغدادي أنّ الحسن بن أشناس كان من علماء عصره المعروفين بحيث أصبح منزله محلاً للدروس يتتلمذ العلماء فيه على يديه.
السبب وراء خلو بعض النسخ من دعاء عرفة
يبدو أنّ النسخ التي لم يرد فيها دعاء عرفة ولا تتمته من كتاب (الإقبال) هي في الحقيقة كتاب (مضمار السباق) الذي اشتمل على أعمال شهر رمضان والفطر، ولما نشر بصورة منفصلة اختلط الأمر وصار يطلق عليه اسم (الإقبال) خطأً.
وطُبع أيضاً كتاب (الإقبال) بخصوص أعمال شهر محرم الحرام حتّى جمادى الآخرة بشكلٍ مستقل، لذا جاء خالياً من دعاء عرفة وتتمته، كما كان في النسخة التي تحمل الرقم 63 في مكتبة المدرسة الجعفرية زهان، وتاريخ تدوينها القرن 11 أو 12 وكانت على شكل ترجمة لكتاب (الإقبال)([578]) وكذا حال النسخة التي تحمل الرقم 147 في مكتبة ملك، وتاريخ تدوينها 1115 ﻫ حيث جاء فيها ذكر أعمال ثلاثة أشهر: رجب، شعبان، وشهر رمضان؛ لذا خلت من دعاء عرفة([579]).
يعدّ كتاب (إقبال الأعمال) واسمه الكامل (الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يُعمل مرّة في السنة) المصدر الرئيس لدعاء عرفة وتتمته، وهو من كتب السيّد ابن طاووس التي عرفت باسم (المهمات لصلاح المتعبد والتتمات لمصباح المتهجد)؛ يحتوي هذا الكتاب على تأليفين، أي كتابين منفصلين أحدهما (مضمار السباق واللحاق بصوم شهر إطلاق الأرزاق عتاق الأعتاق) المختصّ بأعمال شهر رمضان وعيد الفطر، والآخر (الإقبال بالأعمال) ويذكر فيه أعمال باقي أشهر السنة، وبما أنّ الكتابين يكمل أحدهما الآخر تمّ طبعهما في كتاب واحد تحت عنوان (إقبال الأعمال) لأجل جمع أعمال السنة كلها في مؤلَّف واحد.
تبدأ تتمة دعاء عرفة بعبارة: «إِلَهِي أَنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَايَ» وتنتهي بجملة «وَالحمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ». لكن اختلفت الآراء بخصوصها وصحّة نسبتها لسيّد الشهداء×:
يرى كثير من العلماء الشيعة أنّ نسبة تتمة دعاء عرفة للإمام من المسلّمات؛ وذلك لأنّ ما اشتملت عليه التتمة من المعاني الرفيعة والسامية لا يمكن أن تصدر من غير المعصوم، وهذا ما أغناهم عن البحث السَندي.
2 ـ إنّها ليست من إنشاء الإمام×
هناك من قطع جازماً بعدم صحّة انتساب تتمة دعاء عرفة لسيّد الشهداء× ويرى أنّها من إنشاءات الصوفية، دون أن يبدي عن اسم القائل. وممن يذهب إلى هذا القول العلامة المجلسي، وسنقوم بنقل كلامه لاحقاً.
كما نفى بعضهم تتمة الدعاء إلى الإمام الحسين× وقطع بانتسابه إلى ابن عطاء الله الإسكندراني أحد صوفية أهل السنّة؛ حيث جاءت هذه التتمة في كتابه المعنون بـ(الحكم العطائية). من الذين ذهبوا إلى هذا القول: جلال الدين همائي، والعلامة الطهراني، وسنشير إلى كلامهما بهذا الخصوص لاحقاً.
تردد البعض في نسبتها لسيّد الشهداء× بعد ملاحظة أدلّة الطرفين والنسخ المتعددة لكتاب (إقبال الأعمال) الذي يمثّل المصدر الأساسي لدعاء عرفة، فلم يستطع ترجيح طرف على آخر. ومن الذين اختاروا هذا الرأي ـ من باب المثال ـ محمّد مهدي الكرباسجي، حيث بحث هذه المسألة في رسالته لنيل درجة الماجستير، ومدى ارتباطها بالإمام الحسين×.
5 ـ إنّها من إنشاء السيّد ابن طاووس
وهناك من نسب التتمة للسيّد ابن طاووس؛ نظراً لما يتمتّع به من قدرةٍ روحية عالية تمكنه من ذلك، ونُقل هذا كاحتمالٍ عن آية الله العظمى الشيخ بهجت([580]).
والوجه في ذلك أنّ السيّد ابن طاووس ذكر في كتابه (الإقبال) نحوين من الأدعية، فما كان وارداً في الروايات نسبه إلى الأئمة^ وما لم يكن كذلك، أي كان من إنشائه لم ينسبه إليهم^، وحيث إنّ هذه التتمة تقرأ يوم عرفة وبعد قراءة دعاء عرفة من قبل السيّد فقد أُلهم السيّد حينها تلك التتمة من قبل سيّد الشهداء×، لذا ذكرها في بعض نسخ كتاب الإقبال بعد دعاء عرفة.
قرائن وأدلّة المثبتين
ذكرنا سابقاً أنَّ هناك آراء مختلفة في نسبة تتمة دعاء عرفة لسيّد الشهداء×، ونحاول هنا أن نذكر ما اعتمد عليه المثبتون من أدلّة وشواهد على صحّة ما ذهبوا إليه:
أ) وجود هذه التتمة في أكثر نسخ الإقبال
بما أنّ نسخ كتاب الإقبال لم تكن متطابقة، وجدنا من المناسب الإشارة إلى بعض النسخ التي تشتمل على صدر دعاء عرفة وذيله.
قام محمّد مهدي الكرباسجي بذكر ودراسة جميع هذه النسخ في رسالته التي كتبها بخصوص هذه المسألة([581]).
1ـ نسخة رقم 2080 مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، تاريخ الكتابة: 1062 هجري([582]).
وهذه النسخة كانت ملكاً للمرحوم المحدّث أرموي، وجاء فيها القسم الثاني من الدعاء مع الأخطاء.
2ـ نسخة رقم 13981 مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة، تاريخ التدوين: 1065 هجري([583]).
وذكر فيها القسم الثاني من الدعاء مباشرةً بعده من دون أيّ فاصلة.
3ـ نسخة رقم 12374 مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ التدوين: 1068 هجري([584]).
وفي هذه النسخة تمّ نقل القسم الثاني من الدعاء مباشرة بعد القسم الرئيسي له، كما ذكرت النسخة المعرّبة القسم الثاني من الدعاء أيضاً.
4ـ نسخة رقم 3318 مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة، تاريخ التدوين: 1074 هجري([585]).
نقل هذا الدعاء في الورقة 490، كما نقل القسم الثاني من الدعاء أيضاً.
5ـ نسخة رقم 5824 المكتبة المركزية لجامعة طهران، تاريخ الكتابة: 1084 هجري([586]).
وفي هذه النسخة التي لم ترقم صفحاتها جاءت التتمة بعد الدعاء مباشرة دون أيّ فاصلة.
6ـ نسخة 511/ع المكتبة الوطنية، تاريخ الكتابة: 1088 هجري([587]).
كتبت هذه النسخة بخط جميل جدّاً ولها حاشية مهذبة ونقل فيها دعاء عرفة من صفحة 639 حتّى صفحة 647 پ ثمّ جاءت التتمة حتّى صفحة 650 پ.
7ـ نسخة رقم 1344 مكتبة آية الله المرعشي، تاريخ الكتابة: 1089 هجري([588]).
في هذه النسخة وهي ترجمة لكتاب (الإقبال) نُقل القسم الثاني من الدعاء من الورقة 316 پ حتّى 320 پ بخط جميل جدّاً.
8 ـ نسخة رقم 1015 مكتبة ملك، تاريخ الكتابة: 1091 هجري([589]).
جاءت تتمة دعاء عرفة في هذه النسخة من الصفحة 339 حتّى 342. (وهنا رقّمت الصفحات وليس الأوراق).
9ـ نسخة رقم 3907 مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، تاريخ الكتابة: 1094 هجري([590]).
وختمت زيادة الدعاء المنقولة في هذه النسخة بصفحة 335 ر.
10ـ نسخة رقم 6237 مكتبة آية الله المرعشي، تاريخ الكتابة: 1097 هجري([591]).
وقد نُقل القسم الثاني من الدعاء في هذه النسخة أيضاً.
11ـ نسخة رقم 1171 مكتبة آية الله المرعشي، تاريخ الكتابة: القرن 11 الهجري([592]).
وفي هذه النسخة نقل أصل الدعاء في ثماني صفحات، كما نقلت تتمته في ثلاث صفحات تقريباً.
12ـ نسخة رقم 2183 مكتبة آية الله المرعشي، تاريخ الكتابة: القرن 11 الهجري([593]).
وجاء القسم الثاني من الدعاء في هذه النسخة أيضاً، في حين لم يكن هناك تاريخ معيّن لكتابتها.
13ـ نسخة رقم 12543 مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة، تاريخ الكتابة: القرن 11 الهجري([594]).
وذكرت في هذه النسخة فقرات القسم الثاني من دعاء عرفة بعد الإتيان بنفس الدعاء.
14ـ نسخة رقم 189/36 (7189) مكتبة آية الله الگلپايگاني، تاريخ الكتابة: القرن 11 الهجري([595]).
ونقلت تتمة الدعاء في هذه النسخة أيضاً.
15ـ نسخة رقم 9286 المكتبة المركزية لجامعة طهران، تاريخ الكتابة: 1116 هجري([596]).
ونقل فيها القسم الثاني من الدعاء.
16ـ نسخة رقم 71/20/3951 مكتبة آية الله الگلپايگاني، تاريخ الكتابة: القرن 12 الهجري([597]).
وفيها نقل القسم الثاني من الدعاء أيضاً.
17ـ نسخة رقم 351 د مكتبة كلية إلهيات طهران، تاريخ الكتابة: القرن 11 و 12 الهجري([598]).
وفي هذه النسخة ـ والتي لا تزال محفوظة في مكتبة جامعة طهران المركزية ـ جاءت تتمة الدعاء مباشرةً بعد نفس الدعاء دون أيّ فاصلة أو توضيح.
18ـ نسخة رقم 2623 مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، تاريخ الكتابة: 1201 هجري([599]).
ونقلت تتمة الدعاء في هذه النسخة من ورقة 631 ر حتّى 633 ر.
19ـ نسخة رقم 181 مكتبة گوهرشاد، تاريخ الكتابة: 1308 هجري([600]).
حيث جاء ذكر القسم الثاني من الدعاء في هذه النسخة أيضاً.
20ـ نسخة رقم 12411 مكتبة مجلس الشورى الإسلامي، دون ذكر لتاريخ الكتابة([601]).
جاءت تتمة الدعاء في هذه النسخة المعرّبة من ورقة 187 پ حتّى 188 پ.
21ـ نسخة رقم 9771 مكتبة مدرسة غرب همدان، تاريخ الكتابة: يبدو أنّها كانت أواخر القرن 11 الهجري([602]).
نقلت تتمة الدعاء في النسخة الإلكترونية لهذه النسخة الموجودة في مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة.
22ـ نسخة رقم 90 مكتبة گوهرشاد، تاريخ الكتابة: يبدو أنّها في القرن 13 الهجري([603]).
نقل أيضاً القسم الثاني من الدعاء في هذه النسخة التي خطّت بشكل جميل لكنها نسخة غير كاملة.
هناك من يعترض بأنّ قيمة النسخ التاريخية بما كان أقدم وأصح، ولم ترد تتمة الدعاء في أقدم نسخ كتاب (الإقبال).
نجيب عن ذلك:
أوّلاً: لعل التتمة موجودة في أقدم النسخ لكتاب الإقبال لكنها لم تصل إلى أيدينا.
ثانياً: نسب الشيخ عباس القمي بصورةٍ قطعية وجود تتمة الدعاء في بعض نسخ كتاب الإقبال للسيّد ابن طاووس، وهذا يدلّ على وجود نسخة صحيحة للكتاب عنده، خاصةً أنّ الشيخ& كان معروفاً بخبرته وتبحّره. وعليه فلا يرد إشكال العلامة الطهراني على الشيخ بأنّه لماذا لم يذكر التتمة في بعض نسخ الإقبال.
من الأدلة التي أقامها بعض من نسب تتمة الدعاء للإمام× سموّ مضمون تلك التتمة وعلوّ محتواها، إذ إنّ مثل هذه العبارات لا تصدر إلّا من المعصوم.
لذا يقولون:
«نحن نتحدّى العالم بهذا المقطع الختامي من الدعاء كما نتحدّاه بالقرآن الكريم... ابحثوا في أدعية ومناجاة الداعين السابقين والمناجين فإن عثرتم على مثل هذا الدعاء عندها سنصدق أنّه ليس من المعصوم. إن كان بإمكان غير المعصوم أن يأتي بمثل هذا الدعاء، فليجتمع أهل الصوفية والعارفون اليوم في أنحاء العالم، وليأتوا بما يشبه دعاء الإمام هذا. وإن شاهد أحد كلاماً مشابهاً لهذا الدعاء من الماضين أو العرفاء الحاضرين فإنّنا سنتراجع عن تحدّينا (وهو قولنا: إنّ هذه الجمل صادرة عن المعصوم). لكن إن لم تأتوا بذلك ولن تأتوا به حتماً فاعلموا أنّ هذا المقطع لم يصدر إلّا عن شخصٍ معصوم، وأنّ كلمات هذا الدعاء لتشهد أنّها لم تصدر إلّا ممن بلغ أوج درجات العلم والمعرفة»([604]).
يقول آية الله سعادت پرور:
«بعد المقطع الأوّل، طلب الإمام حوائج أخرى، ثمّ ناجى الإمام الله تعالى بأتمّ كمالاته، بعدها أشار إلى بعض الحوائج، ثمّ بدأ بمناجاة المعبود وكأنّه فنى في الذات الربوبية ونسي نفسه فجرت هذه الكلمات على لسانه: (إِلهِى أَنَا الْفَقِيرُ...). يقول أستاذنا المرحوم العلامة الطباطبائي: (إنّ هذا المقطع من الدعاء لا يتلائم وكلام أيّ فيلسوف أو عارف (لدقّة محتواه وظرائف معانيه)، بل هذا المقال لا يمكن صدوره إلّا عن معصوم مثل سيّد الشهداء×؛ لأنّ هذا الكلام يكاد ينفجر من شرف معانيه وعظمتها)»([605]).
وقال آية الله بهجت:
«جاء في آخر كتاب (الفوائد المدنية) رسالة للسيّد ابن طاووس& وكأنّ المرحوم السيّد هو الأوّل بلحاظ الإحاطة بالروايات والأدعية. وكان يعتقد بالإلهام ويقول: (إنّي لأعرف من يعرف ليلة القدر)، كما كان يُنشئ أدعيةً من نفسه، فتتمة دعاء عرفة إمّا رواية أو من السيّد نفسه. وعلى أي حالٍ إنّ مضمون الدعاء يحتوي على أمور توحيدية تفوق العلوم المتعارفة»([606]).
وقال آية الله الشبيري الزنجاني:
«إنّ السيّد الخميني له باع بالعرفان وقد أدرك علو وسمو مضامين تتمة دعاء عرفة، وذهب إلى أنّ هذا الدعاء صدر من سيّد الشهداء× حقاً، لذا كان يقول: (إذا أراد غير المعصوم إنشاء دعاءٍ كهذا لاحتبس لسانه عن التعبير والبيان)»([607]).
وقال آية الله الشيخ مكارم الشيرازي:
«رغم تردد بعض العلماء في هذه الإضافة من دعاء عرفة، ولكن الإنصاف أنّ هذه الزيادة تشتمل على مضامين رفيعة متناسبة مع أجواء ومفاهيم دعاء عرفة، ولم نجد شيئاً يدلّ على أنّها من إضافات الفرق المنحرفة»([608]).
وكما سنبيّن مفصلاً فيما بعد أنّ المعيار والميزان في اعتبار الرواية مطابقتها للقرآن الكريم والسنّة القطعية، ولم نجد ما يخالفهما في مضامين تتمة دعاء عرفة، بل إنّ أجمعها مطابق للشرع.
د) إضافات من قبل السيّد في (الإقبال)
من المعتاد بين المؤلفين وبعد مرور فترة من الزمن عند عثورهم على معلوماتٍ جديدة تتعلّق بكتبهم يلحقونها بها في الطبعات المتأخرة، كما هو سائد اليوم، حيث نلاحظ في الطبعات المتجددة ـ لأيّ كتاب ـ بعض الإضافات من قبل المؤلّف.
لذا يذكر الشيخ فارس تبريزيان (الحسون) في مقدّمة كتاب (سعد السعود):
«ذكر السيّد ابن طاووس كتاب الإقبال وأنّه مجلّدان: الأوّل من شهر شوال وإلى آخر ذي الحجة، والثاني من شهر محرّم وإلى آخر شهر شعبان، ولم يذكر أعمال شهر رمضان، مع أنّ في مخطوطات كتاب (الإقبال) ومطبوعاته ورد بالتفصيل فيها أعمال شهر رمضان. وهذا يرجع إلى ما أجراه السيّد ابن طاووس على كتابه (الإقبال) من تعديلات وإضافات، فأضاف عليه فيما بعد أعمال شهر رمضان، حتّى أنّه أضاف على مقدّمة كتابه (الإقبال) وصرّح بهذا المطلب»([609]).
ويقول أيضاً في استنتاجه:
«إنّ بين نسخ كتاب (الإقبال) اختلاف كثير وزيادة ونقصان وتقديم وتأخير، والظاهر رجوع هذا الاختلاف إلى المؤلّف نفسه قدّس الله روحه، لا إلى النسّاخ كما تصوّره البعض، حيث ألّفه في مدّة طويلة وأجرى عليه تعديلات بمرور الزمان»([610]).
وأشار أيضاً إلى بعض تلك الإضافات إيتان كولبرغ في (مكتبة ابن طاووس)([611]).
ويمكن الإتيان بعدّة شواهد على هذا المدّعى من السيّد ابن طاووس نفسه:
ذكر السيّد ابن طاووس في كتاب (المضمار) المختصّ بأعمال شهر رمضان، والذي نُشر أخيراً ضمن كتاب (الإقبال):
«وقد وجدنا تعليقة غريبة على ظهر كتاب عتيق وصل إلينا يوم الرابع والعشرين من صفر سنة ستين وستمائة بعد تصنيف هذا الكتاب، ونحن ذاكروها حسب ما رأيناها قريبة من الصواب»([612]).
وكتب أيضاً في نهاية أعمال شهر محرم في فصل عنوانه (فيما نذكره عن يوم ثامن وعشرين من محرم) يوم فتح بغداد بيد هولاكو خان:
«...وينبغي أن يختم شهر محرم بما قدّمناه من خاتمة أمثاله، ونسأل الله تعالى أن لا يخرجنا من حماه عند انفصاله، وهذا الفصل زيادة في هذا الجزء بعد تصنيفه في التاريخ الذي ذكرناه»([613]).
وقال العلّامة أبو الحسن الشعراني:
«رأيت في مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة نسخة قديمة ومعتبرة لكتاب (الإقبال) بهذه الزيادة، ولم ينقلها الكفعمي، ولعلّ ذلك يعود إلى النسخة التي عنده؛ لأنّني رأيت بنفسي أنّ هناك سقطاً كثيراً في بعض نسخ (الإقبال) وقد حُذفت منها عدّة أدعية بما فيها هذه الزيادة»([614]).
هـ) احتمال وجود سند آخر لتتمة دعاء عرفة
هناك حاشية في نسخة رقم 10583 في مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة والمدوّنة في 1076 من التاريخ الهجري([615])، منسوبة للملّا محسن الفيض الكاشاني أو محسن ابن محمّد الأسترآبادي (احتمال راجح)، يقول فيها:
«اعلم أنّ الشيخ الكفعمي& في كتابه المسمى بالبلد الأمين روى هذا الدعاء من كتاب (مصباح الزائر) للسيّد طاب ثراه من بشر وبشير ابنا غالب الأسدي إلى قوله×: (يَا رَبِّ يَا رَبِّ) ولم يرو التتمة، فالظاهر أنّ تلك الزيادة التي نقلها السيّد هنا هي التي دعا بها× عقيبه وحده والناس يؤمّنون، ولم يضبطها الراويان المذكوران ووصل إلى السيّد بسند آخر ضبطها راويها، فإنّ في الرواية أنّه× جهد وبالغ في كلمة (يَا رَبِّ يَا رَبِّ) وشغل من حضر ممن كان حوله عن الدعاء لأنفسهم فأقبلوا على الاستماع له× والتأمين على دعائه×، واحتمل بعض إلحاق هذه التتمة نظراً إلى مخالفته السياق ووجود الفقرات المحمولة على غير ظاهرها فيه، وربّما يؤيده عدم كون هذه الزيادة في نسخة عتيقة من (الإقبال) التي تاريخ كتابته قرب من عصر السيّد&»([616]).
و) إذعان المحدّث القمي بوجود ذيل دعاء عرفة في بعض نسخ الإقبال
ذكر المحدّث القمي ـ الذي كان من ذوي الخبرة والاطلاع بالأحاديث والأدعية ـ في ذيل أعمال يوم عرفة:
«ومن جملة الأدعية المشهورة في هذا اليوم دعاء سيّد الشهداء×»([617]).
وبعد ما أورد أصل الدعاء ـ نقلاً عن الكفعمي ـ إلى آخره أي قوله: (يا رب يا رب) قال:
«أقول: إلى هنا تمّ دعاء الحسين× في يوم عرفة على ما أورده الكفعمي في كتاب (البلد الأمين) وقد تبعه المجلسي في كتاب (زاد المعاد) ولكن زاد السيّد ابن طاووس في (الإقبال) بعد: يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ هذه الزيادة: (إِلهِي أَنا الفَقِيرُ فِي غِنايَ فَكَيْفَ لا أَكُونُ فَقِيراً فِي فَقْرِي...)»([618]).
فهنا ينسب المحدّث القمي الزيادة بصورة قطعية للسيّد ابن طاووس، وحينما ندقق في كلماته نصل إلى أنّه كان يعتمد على نسخةٍ معتبرةٍ عنده لكتاب الإقبال تتضمّن هذه الزيادة لدعاء عرفة.
يبيّن المحدّث القمي مبناه ومنهجه في مقدّمة كتابه (مفاتيح الجنان) بقوله:
«يقول البائس الفقير المُتمسِّك بأحاديث أهل البيت^، عبّاس بن محمّد رضا القمّي ختم الله لَهُما بالحسنى والسعادة: قد سَألني بَعض الإخوان مِنَ المؤمنين أن أراجع كتاب مفتاح الجنان المُتداول بين النّاس فَأُؤلّف كتاباً على غراره خلوّا ممّا احتواه ممّا لم أعثر على سَنده مقتطفاً منهُ ما كانَ لَهُ سَند يَدعَمهُ...»([619]).
وقال أيضاً في موضع آخر:
«وإنّما ألّفته إتماماً للحجّة عليهم فجددت واجتهدت في أخذ الأدعية والزيارات الواردة في هذا الكتاب عن مصادرها الأصيلة وعرضها على نسخ عديدة كما بذلت أقصى الجهد في تصحيحها واستخلاصها من الأخطاء كي يثق به العامل ويسكن إليه إن شاء الله»([620]).
والملفت للنظر أنّ المحدّث القمي كان على يقينٍ بإشكال العلامة المجلسي، لكنه لم يبال بذلك ونسب تتمة الدعاء إلى الإمام الحسين×، وهذا دليل على عدم مبالاة المحدّث بالإشكال رغم تبحّره بعلم الحديث.
ولذا نجد الكثير من الفقهاء ومراجع التقليد يأتون على ذكر تلك الزيادة بعد دعاء عرفة في كتبهم حول (مناسك الحج)، من أمثال:
1ـ آية الله السيّد علي السيستاني([621]).
2ـ آية الله محمّد تقي بهجت([622]).
3ـ آية الله السيّد علي الخامنئي([623]).
4ـ آية الله حسين الوحيد الخراساني([624]).
5ـ آية الله السيّد موسى الشبيري الزنجاني([625]).
6ـ آية الله ناصر مكارم الشيرازي([626]).
7ـ آية الله جعفر السبحاني([627]).
8ـ آية الله السيّد كاظم الحائري([628]).
9ـ آية الله محمّد إسحاق الفياض([629]).
ز) احتمال الاختلاف في أسلوب السيّد ابن طاووس
لعل عدم الانسجام في نسخ (كتاب الإقبال) يعود إلى طريقة السيّد ابن طاووس في التأليف كما صرّح بذلك في كتاب (الإقبال):
«الثماني مجلدات لم يكن لها عندي مسودات، على عادة من يريد التصنيف ويرغب في التأليف، وإنّما كان عندنا ناسخ نملي ما يجريه الله جل جلاله على خاطرنا من المقال، وما يفتحه على سرائرنا من أبواب الإقبال، أو نكتبه في رقيعات وينقله الناسخ في الحال. وأمّا ما كنّا نحتاج إلى روايته من الأخبار المنقولات أو نذكره من الدعوات، فتارة كنّا نمليه على الناسخ من الكتاب الذي روينا عنه أو أخذناه منه، وتارة ندل الناسخ على المواضع التي نريد خدمة الله جل جلاله فضل أطرافها وتكميل أوصافها فينقلها من أصولها كما عرفناه من تحصيلها، فالمبيضة التي كتبها الناسخ في [هي] مسودة المصنفات المذكورات. فإن وجد فيها خلل فلعل ذلك لأجل هذه القاعدة المخالفة لعادات المصنفين»([630]).
بعدما ذكرنا أدلة المثبتين لنسبة تتمة دعاء عرفة للإمام الحسين×، نتطرّق هنا لذكر أدلة النافين ومناقشتها.
أ) عدم وجود الإضافة في بعض نسخ كتاب (الإقبال)
قال البعض: من نقاط ضعف هذه التتمة عدم وجودها في بعض نسخ كتاب (الإقبال).
أفاد العلّامة الحسيني الطهراني قائلاً:
«إنّ هذا الدعاء لا يمكن أن نجده في كتب أدعية الشيعة إلّا في النسخ المطبوعة لكتاب (الإقبال) للسيّد ابن طاووس رضوان الله عليه، وفي كتاب آخر هو (مفاتيح الجنان) للمحدّث المعاصر المرحوم الحاج الشيخ عبّاس القمّي&، حيث نسباه إلى سيّد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلوات في تتمّة دعاء يوم عرفة وذيله.
ومحصّل الكلام أنّه وطبقاً لرواية الكفعمي في حاشية كتاب (البلد الأمين) فإنّ السيّد حسيب (نسيب رضي الدين علي بن طاووس+) قال في كتاب (مصباح الزائر) ما قوله:
روي بِشر وبشير (ابنا غالب الأسدي) أنّ الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب÷ خرج من خيمته عصر يوم عرفة في عرفات في خضوع وخشوع وسار بهدوء حتّى وقف هو وجماعة من أهل بيته وأولاده وغلمانه عند الجانب الأيسر لجبل عرفات [جبل الرحمة] مولّين وجوههم شطر البيت الحرام، ثمّ رفع يديه أمام وجهه كالمسكين الذي يطلب الطعام وبدأ بقراءة هذا الدعاء: الحَمْدُ لِلهِ الذي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ ـ إلى آخر الدعاء والذي آخره يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وليس في آخره العبارات إلَهِي أنَا الفَقِيرُ في غِنَايَ ـ إلى آخره. (كان هذا ما ورد في حاشية (البلد الأمين) [والتوضيح الأخير هو لنا]).
ثمّ روي السيّد ابن طاووس رواية بِشر وبَشير اللذين كانا من قبيلة (بني أسد) في كتاب (مصباح الزائر) في الكلام عن يوم عرفة بنفس الشكل الذي أوردناه نحن في حاشية (البلد الأمين)، ثمّ روي هذه الرواية حسب مضمون (البلد الأمين)([631]).
كان ذلك هو كلام المجلسي& في (بحار الأنوار). ثمّ ذكر عدّة أدعية أخرى عن السيّد ابن طاووس في يوم عرفة، ثمّ قال: وقال السيّد: ومن الدعوات المشرّفة في يوم عرفة دعاء مولانا الحسين بن على صلوات الله عليه وهو: الحَمْدُ لِلهِ الذي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ وَلَا لِعَطَائِهِ مَانِعٌ.
وهنا ينقل ابن طاووس هذا الدعاء المفصّل عنه (الإمام الحسين×) مع هذه الإضافة:
إلَهِي أنَا الفَقِيرُ في غِنَايَ فَكَيْفَ لَا أكُونُ فَقِيراً في فَقْرِي ـ حتّى يختم الدعاء بالعبارة:
أمْ كَيْفَ تَغِيبُ وَأنْتَ الرَّقِيبُ
الحَاضِرُ، إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَالحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ ـ
انتهى كلامه.
ثمّ يقول المجلسي: قد أورد الكفعمي أيضاً هذا الدعاء في (البلد الأمين) وابن طاووس في (مصباح الزائر) كما سبق ذكرهما، ولكن ليس في آخره فيهما بقدر ورقة تقريباً وهو من قوله: إلَهِي أنَا الفَقِيرُ في غِنَايَ إلى آخر هذا الدعاء.
وكذا لم توجد هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من (الإقبال) أيضاً، وعبارات هذه الورقة لا تلائم سياق أدعية السادة المعصومين أيضاً، وإنّما هي على وفق مذاق الصوفيّة، ولذلك قد مال بعض الأفاضل إلى كون هذه الورقة من مزيدات بعض مشايخ الصوفيّة ومن إلحاقاته وإدخالاته.
وبالجملة، هذه الزيادة إمّا وقعت من بعضهم أوّلاً في بعض الكتب، وأخذ ابن طاووس عنه في (الإقبال) غفلةً عن حقيقة الحال، أو وقعت ثانياً من بعضهم في نفس كتاب (الإقبال)، ولعلّ الثاني أظهر على ما أومأنا إليه من عدم وجدانها في بعض النسخ العتيقة وفي (مصباح الزائر)، والله أعلم بحقيقة الأحوال([632]).
وأمّا المرحوم المحدّث القمّي، فقد ذكر بعد نقل هذا الدعاء إلى (يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ)، أنّ الإمام كان يكثر من قول: يَا رَبِّ، وأمّا الذين كانوا يستمعون إلى الدعاء، من الذين اجتمعوا من حوله، كانوا يكتفون بقول آمين.
ثمّ علت أصوات بكائهم مع الإمام× حتّى غروب الشمس، ثمّ حزموا أمتعتهم باتّجاه المشعر الحرام.
يقول المؤلّف (المحدّث القمّي): إنّ الكفعمي نقل دعاء عرفة للإمام الحسين× في كتاب (البلد الأمين) إلى هذه الفقرة([633])، وأورد العلامة المجلسي في (زاد المعاد)([634]) هذا الدعاء الشريف كما في رواية الكفعمي، إلّا أنّ السيّد ابن طاووس في كتابه (الإقبال) قد زاد على الدعاء المذكور بعد يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ قائلًا: إلَهِي أنَا الفَقِيرُ في غِنَايَ.
وقد نقل جميع تلك الفقرات بالتفصيل وزاد عليها في آخرها عبارة: إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، وَالحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ([635])([636]).
نعم، فإنّ هذه المناجاة والحِكَم المنقولة عن ابن عطاء الله هي في الحقيقة من تأليفه هو، وإسنادها إلى سيّد الشهداء الإمام الحسين× غير صحيح.
فكيف يتسنّى للمرحوم السيّد ابن طاووس، وهو المتوفّى في 5 ذي القعدة سنة 664([637]) أن يتصوّر أنّ هذه الفقرات من ابن عطاء الله، وهو المتوفّى في جمادى الآخرة سنة 709([638])، وينسبها إلى الإمام×؟! فالفاصل الزمني بين وفاة هذين الشخصين هو 44 سنة وسبعة أشهر، وبذلك يكون السيّد خلال هذه المدّة، والتي تقرب من نصف قرن، قد توفّي قبل تأليف هذه الأدعية، وعلى هذا يمكن الجزم بأنّ إلحاق هذه الفقرات بدعاء الإمام في يوم عرفة في كتاب (الإقبال) قد تحقّق بعد رحيل السيّد؛ وعليه فإنّ الاحتمال الثاني للعلامة المجلسي& سيكون يقيناً، وأمّا الاحتمال الأوّل الذي يقول فيه: ربّما يكون قد ورد في كتب البعض، ثمّ قام ابن طاووس بنقل ذلك بدون دراية، فهو غير صحيح.
كلّا وحاشا أن يكون السيّد وهو الذي يمتلك تلك العظمة والمنزلة، قد اقتبس هذا الكلام من كتاب عارفٍ، وألحقه في آخر دعاء الإمام، ثمّ نسبه إلى الإمام.
والدليل على ذلك، عدم ذكر السيّد له في كتاب (مصباح الزائر)، وعدم ورود ذلك في المخطوطات القديمة من كتاب (الإقبال)، أي أنّ هذه النسخ كانت موجودة في حياة السيّد، ونُسبت إليه بعد وفاته، إلّا أنّ المجلسي ولعدم علمه بكتاب (الحِكَم العطائيّة)، ولا بمؤلّفه، أو زمان تأليفه، قد أخطأ في إسناده هذا. وأمّا خطأ المحدّث القمّيّ وهو الخبير في فنّ البحث والتأليف، فهو أنّه وبعد أن رأى كلام العلامة المجلسي& القائل: لم نعثر على هذه الفقرات من الدعاء في النسخ القديمة من كتاب (الإقبال)، قال في (مفاتيح الجنان): ولكن ذكر السيّد ابن طاووس في (الإقبال) بعد كلمة يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ هذه الزيادة.
ذلك أنّ هذه العبارة تؤكّد إسناد هذا الدعاء إلى السيّد ابن طاووس، وكان عليه أن يقول: وقد شوهدت هذه الإضافة في بعض نسخ كتاب (الإقبال).
وحصيلة الكلام، أنّ هذا الدعاء جيّد المضامين، ولطيف المعاني، وقراءته في كلّ وقت وحين مفيدة ونافعة، إلّا أنّه لا يجوز إسناده إلى سيّد الشهداء×. وَالحَمْدُ لِلهِ أوَّلاً وَآخِراً، وَظَاهِراً وَبَاطِناً»([639]).
أوّلاً: كما ذكرنا سابقاً، أنّ نتيجة الفحص والتدقيق في النسخ القديمة لكتاب (إقبال الأعمال) للسيّد ابن طاووس من قبل ذوي الخبرة أنّ هذه الزيادة قد وردت في 26 نسخة منها، ولم تفتقدها إلّا خمس نسخ فحسب([640]).
ثانياً: يحتمل أنّ السيّد ابن طاووس قد ألحق هذه الزيادة بكتابه في أواخر عمره الشريف، في حين قام النسّاخ باستنساخ هذا الكتاب من نسخه المختلفة، ولذا يقول الحاج الشيخ عباس القمي& قبل ذكره هذه الزيادة:
«ذكر السيّد ابن طاووس في الاقبال بعد (يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ) هذه الزيادة...»([641]).
والشاهد على هذا المدّعى أنّ هناك من نقل دعاء عرفة عن كتاب (مصباح الزائر)، بينما النسخة الموجودة من كتاب (مصباح الزائر) خالية من دعاء عرفة وتتمته، وهذا بدوره يدلّ على وجود نسختين لهذا الكتاب وتمّ نقل الدعاء من تلك النسخة التي أورد فيها السيّد ابن طاووس الدعاء وتتمته.
ثالثاً: استند العلامة الطهراني في كتابه (معرفة المعاد) بذيل الدعاء وقال:
«وقد ورد في ذيل دعاء عرفة لسيّد الشهداء× حسب رواية ابن طاووس قوله:
إلَهِي عَلِمْتُ بِاخْتِلَافِ الآثَارِ وتَنَقُّلَاتِ الأطْوَارِ أنَّ مُرَادَكَ مِنِّي أنْ تَتَعَرَّفَ إلَي في كُلِّ شَيءٍ حَتَّى لَا أجْهَلَكَ في شَيْءٍ.
إلى أن يصل إلى قوله:
إِلَهِي أمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إلَى الآثَارِ فَارْجِعْنِي إلَيْكَ بِكِسْوَةِ الأنْوَارِ وَهِدَايَةِ الاسْتِبْصَارِ حَتَّى أرْجِعَ إلَيْكَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ إلَيْكَ مِنْهَا مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إلَيْهَا وَمَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ الاعْتِمَادِ عَلَيْهَا.
إلى أن يصل إلى قوله:
أنْتَ الَّذِي أشْرَقْتَ الأنْوَارَ في قُلُوبِ أوْلِيَائِكَ حَتَّى عَرَفُوكَ وَوَحَّدُوكَ، وَأنْتَ الَّذِي أزَلْتَ الأغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أحِبَّائِكَ حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ وَلَمْ يَلْجَؤوا إلَى غَيْرِكَ، أنْتَ المؤْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ أوْحَشَتْهُمُ الْعَوَالِمُ، وَأنْتَ الَّذِي هَدَيْتَهُمْ حَيْثُ اسْتَبَانَتْ لَهُمُ المعَالِمُ، مَا ذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ؟! وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ؟!»([642]).
وقال في تعليقته على هذا الكلام:
«هذه المطالب ضمن ذيل دعاء عرفة لسيّد الشهداء× في موقف عرفة، وقد أوردها السيّد الأجل علي بن طاووس في كتاب (الإقبال) ص 348 و 349، ونقلها المرحوم المجلسي رضوان الله عليه في المجلّد العشرين من (بحار الأنوار) ص 286 عن كتاب (الإقبال)، وله في ذيل هذا الدعاء كلام ننقله هنا نصّاً: قد أورد الكفعمي رحمة الله عليه أيضاً هذا الدعاء في (البلد الأمين)، وابن طاووس في (مصباح الزائر) كما سبق ذكرهما. ولكن ليست في آخره فيهما بقدر ورقة تقريباً، وهو من قوله: (إلهي أنا الفقير في غناي) إلى آخر هذا الدعاء، وكذا لم توجد هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من (الإقبال) أيضاً. وعبارات هذه الورقة لا تلائم سياق أدعية السادة المعصومين أيضاً، وإنّما هي على وفق مذاق الصوفيّة، ولذلك قد مال بعض الأفاضل إلى كون هذه الزيادة من مزيدات بعض مشايخ الصوفيّة ومن إلحاقاتهم وإدخالاتهم.
وبالجملة، هذه الزيادة إمّا وقعت من بعضهم أوّلاً في بعض الكتب، وأخذ ابن طاووس عنه في (الإقبال) غفلةً عن حقيقة الحال، أو وقعت ثانياً من بعضهم في نفس كتاب (الإقبال)، ولعلّ الثاني أظهر على ما أومأنا إليه من عدم وجدانها في بعض النسخ العتيقة وفي (مصباح الزائر)، والله أعلم بحقائق الأحوال ـ انتهى.
وأنا أقول: إنّ هذه الفقرات من الدعاء ذكرها العارف المشهور أحمد بن محمّد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري المتوفى سنة 709 هجريّة في كتابه المسمّى بـ(الحِكم العطائيّة والمناجاة الإلهيّة) حيث عُدّت من جملة أدعية هذا العارف ومناجاته. وكانت وفاة ابن طاووس على ما في (أعيان الشيعة) ج 42، ص 184، في سنة 664 هجريّة، فإذا صحّت نسبة هذا الدعاء إلى ابن عطاء فمن المستبعد أن ينقلها ابن طاووس في كتابه في حين أنّ ابن عطاء توفي بعد ابن طاووس بـ(45 سنة)، لذا فإنّ الاحتمال الثاني للمجلسي أرجح. ولكن يمكننا أن نقول: إنّ هذا الدعاء لسيّد الشهداء× نفسه بَيدَ أنّ ابن طاووس لم يعثر على هذه الفقرة عند تأليف (مصباح الزائر) وأوردها في (الإقبال)، ثمّ نقل ابن عطاء ـ وكان معاصراً لابن طاووس ومتأخّراً عنه ـ هذا الدعاء عن ابن طاووس وذلك في كتابه (الحكم) وكان يُناجي به، لذا عُدّ من مناجاته بعد وفاة ابن عطاء»([643]).
وصرّح في كتاب (نور ملكوت القرآن) قائلاً:
«يقول المعلّم الذي جسّد حقيقة القرآن أبو عبد الله الحسين سيّد الشهداء× في دعاء عرفة في أرض عرفات:
إلَهِي عَلِمْتُبِاخْتِلاَفِالآثَارِوَتَنَقُّلاَتِالأطْوَارِ، أَنّمُرَادَكَمِنِّيأَنْتَتَعَرَّفَ إِلَيَّ فِي كُلِّشَيْءٍحَتَّيلاَأَجْهَلَكَفِيشَيءٍ.
إلى أن يقول: إلَهِيتَرَدُّدِيفِيالآثَارِيُوجِبُبُعْدَالمَزَارِ، فَاجْمَعْنِي عَلَيْكَبِخِدْمَةٍ تُوصِلُنِي إِلَيْكَ، كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ؟! أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّي يَكُونَ هُوَ المُظْهِرَ لَكَ؟! مَتَي غِبْتَحَتَّي تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ؟! وَمَتَي بَعُدْتَحَتَّيتَكُونَالآثَارُهِيَالَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ؟!
عَمِيَتْ عَيْنٌ لاَ تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيباً.
إلَهِي أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْآثَارِ فَارْجِعْنِي إِلَيْكَ بِكِسْوَةِ الْأَنْوَارِ وَهِدَايَةِ الاسْتِبْصَارِ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ إِلَيْكَ مِنْهَا مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَمَرْفُوعَ الهِمَّةِ عَنِ الاعْتِمَادِ عَلَيْهَا، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
إلى أن يقول: أَنْتَالَّذِيأَشْرَقْتَالاَنْوَارَفِيقُلُوبِأَوْلِيَائِكَحَتَّيعَرَفُوكَوَوَحَّدُوكَ، وَأَنْتَالَّذِيأَزَلْتَالأغْيَارَعَنْقُلُوبِأَحِبَّائِكَحَتَّيلَمْيُحِبُّواسِوَاكَ وَلَمْ يَلْجَؤوا إِلَى غَيْرِكَن أَنْتَ المُؤْنِسُ لَهُمْ حَيْثُ أَوْ حَشَتْهُمُ العَوَالِمُ، وَأَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَهُمْحَيْثُاسْتَبَانَتْلَهُمُالمَعَالِمُ.
مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَكَ؟! وَمَا الَّذِي فَقَدمَنْوَجَدَكَ؟!
إلى أن يصلإلى قوله: أَنْتَ الذَّاكِرُ قَبْلَ الذَّاكِرِينَ، وَأَنْتَ البَادِي بِالإحْسَانِقَبْلَتَوَجُّهِالعَابِدِينَ، وَأَنْتَالجوَادُبِالْعَطَاءِقَبْلَطَلَبِالطَّالِبِينَ، وَأَنْتَالْوَهَّابُثُمَّلِمَاوَهَبْتَلَنَامِنَالمسْتَقْرِضِينَ.
إلى أن يقول: أَنْتَالَّذِي لاَإلَهَغَيْرُكَ، تَعَرَّفْتَلِكُلِّشَيْءٍفَمَاجَهِلَكَشَيْءٌ، وَأَنْتَالَّذي تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيءٍفَرَأَيْتُكَظَاهِراًفِيكُلِّشَيءٍ، وَأَنْتَالظَّاهِرُلِكُلِّشَيءٍ.
وهذه هيحالاتاندكاكالإماموفنائهفيذات الحضرةالأحديّة، وهوأمرمشهودفيهذهالمناجاة»([644]).
ب) عدم وجود الزيادة في أقدم نسخ الإقبال
من جملة ما أورد من الإشكالات أنّ هذه التتمة لم يعثر عليها في أقدم نسخ كتاب (الإقبال).
يقول العلامة المجلسي:
«أقول: قد أورد الكفعمي& أيضاً هذا الدعاء في (البلد الأمين) وابن طاوس في (مصباح الزائر) كما سبق ذكرهما، ولكن ليس في آخره فيهما بقدر ورق تقريباً وهو من قوله: (إِلَهِي أَنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَايَ) إلى آخر هذا الدعاء، وكذا لم يوجد هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من الإقبال أيضاً، وعبارات هذه الورقة لا تلائم سياق أدعية السادة المعصومين أيضاً وإنّما هي على وفق مذاق الصوفية، ولذلك قد مال بعض الأفاضل إلى كون هذه الورقة من مزيدات بعض مشايخ الصوفية ومن إلحاقاته وإدخالاته. إنّ هذه الإضافات إمّا أنّها جاءت بدايةً في بعض كتبهم ونقلها ابن طاووس في (الإقبال) غافلاً عن حقيقتها، أو أنّ بعضهم ألحقها بالدعاء فيما بعد، لعلّ الاحتمال الثاني هو الأنسب؛ لأنّنا ذكرنا بأنّ هذه الإضافة تفتقدها بعض النسخ القديمة من كتاب (الإقبال)، كما أنّ السيّد مؤلف (الإقبال) لم يرو ذلك في كتابه (مصباح الزائر) الخاص بالأدعية، والله أعلم بحقائق الأحوال»([645]).
إنّ ما ذهب إليه العلامة المجلسي وما حكم به بخصوص تتمة دعاء عرفة، يمكن أن يناقش من عدّة جهات:
أوّلاً: لعلّ عدم العثور على تتمة دعاء عرفة في أقدم نسخ (الإقبال) يعود إلى أنّ السيّد أو غيره ألحق التتمة بالكتاب المذكور فيما بعد، لذا توفرت التتمة في نسخ دون أخرى.
ذكرنا سابقاً وجود حاشية في نسخة رقم 10583 من مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة المدوّنة في 1076 من التاريخ الهجري([646])، منسوبة للملّا محسن الفيض الكاشاني أو محسن بن محمّد الأسترآبادي (احتمال راجح)، حيث يقول:
«اعلم أنّ الشيخ الكفعمي& في كتابه المسمّى بالبلد الأمين روى هذا الدعاء من كتاب (مصباح الزائر) للسيّد طاب ثراه من بشر وبشير ابنا غالب الأسدي إلى قوله×: (يَا رَبِّ يَا رَبِّ) ولم يرو التتمة، فالظاهر أنّ تلك الزيادة التي نقلها السيّد هنا هي التي دعا بها× عقيبه وحده والناس يؤمّنون، ولم يضبطها الراويان المذكوران ووصل إلى السيّد بسندٍ آخر ضبطها راويها، فإنّ في الرواية أنّه× جهد وبالغ في كلمة (يَا رَبِّ يَا رَبِّ) وشغل من حضر ممن كان حوله عن الدعاء لأنفسهم فأقبلوا على الاستماع له× والتأمين على دعائه×، واحتمل بعض إلحاق هذه التتمة نظراً إلى مخالفته السياق ووجود الفقرات المحمولة على غير ظاهرها فيه، وربّما يؤيده عدم كون هذه الزيادة في نسخة عتيقة من (الإقبال) التي تاريخ كتابته قرب من عصر السيد×»([647]).
ثانياً: إنّ عدم وجود تتمة دعاء عرفة في بعض نسخ (الإقبال) القديمة لا يضرّ باعتبار هذا المقطع من الدعاء. إنّ ما قاله العلامة المجلسي بهذا الخصوص عبارة عن:
«وكذا لم يوجد هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من الإقبال أيضاً»([648]).
إنّما يتوجّه الضرر فيما لو لم توجد التتمة في كل النسخ القديمة لـ(الإقبال)، أمّا وجودها في بعض النسخ دون أخرى فلا يعدّ ضرراً على صحّة واعتبار هذا المقطع من الدعاء.
لو أنّ هذه الزيادة غير موجودة في جميع نسخ (الإقبال) القديمة، لكان ذلك مدعاةً للإشكال، أمّا كونها موجودة في بعض النسخ القديمة دون غيرها فإنّه لا يضرّ بصحة هذه التتمة. وهنا علينا التدقيق في شأن تلك النسخة التي لا تتوفر فيها تتمة الدعاء، فإن كانت هي الراجحة على غيرها من النسخ القديمة فكلام الناقد صحيح، وأمّا مجرد كونها نسخة قديمة لا تحتوي على تلك التتمة مع وجود نسخ قديمة بل وجديدة لهذا الكتاب تحتوي على التتمة فهو مما لا يثير الإشكال ولا يؤثر على الاعتبار، فلربما وقع خلل في تلك النسخة الخالية من التتمة.
والعجيب من العلامة المجلسي كيف أنّه يشكك هنا في نسبة تتمة الدعاء للإمام الحسين×، ولكنه في موضع آخر يقطع بتلك النسبة، حيث يقول:
«وَفِي كَلَامِ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الحسَيْنِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَى جَدِّهِ وَأَبِيهِ، وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ، وَعَلَيْهِ وَبَنِيهِ، مَا يُرْشِدُكَ إِلَى هَذَا الْعِيَانِ، بَلْ يُغْنِيكَ عَنْ هَذَا الْبَيَانِ، حَيْثُ قَالَ فِي دُعَاءِ عَرَفَةَ:
(كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ؟! أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المظْهِرَ لَكَ؟! مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ؟! وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ؟! عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ، وَلَا تَزَالُ عَلَيْهَا رَقِيباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيباً).
وَقَالَ أَيْضاً: (تَعَرَّفْتَ لِكُلِّ شَيْءٍ فَمَا جَهِلَكَ شَيْءٌ). وَقَالَ: (تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَرَأَيْتُكَ ظَاهِراً فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَأَنْتَ الظَّاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ)»([649]).
فليس أمامنا سوى أن نقول قد تراجع فيما يبدو عن رأيه.
ثالثاً: لم تحتو هذه التتمة في دعاء عرفة على أيّ مضمون مخالف للعقل أو القرآن والسنّة، بل جميع ما فيها عبارة عن معانٍ رفيعة مستلهمة من النصوص الإسلامية، والمواضع التي قد تنالها يد الإشكال سنجيب عنها فيما بعد.
رابعاً: لا يليق بشأن العلماء مع ما هم عليه من دقّة النظر والقداسة ومن جملتهم السيّد ابن طاووس طرح احتمال تساهلهم في نقل تتمة الدعاء في نصوصهم ونسبتها إلى الإمام الحسين× مع كونها من الصوفية.
خامساً: لماذا احتمل العلامة المجلسي التساهل بالأمر في حق علماء الشيعة، مع إغماضه عن وجود احتمال الطرف الآخر في المسألة، وهو أنّ ابن عطاء الله الإسكندراني قد أخذ التتمة من سيّد الشهداء× وكانت مكتوبة عنده يقرأها في مناجاته، ووجدها تلاميذه بين مسودّاته فيما بعد، فنسبوها إليه ومن ثمّ طبعوها؟ كما أورد ذو النون المصري بعض الفقرات من دعاء عرفة في مناجاته.
ج) عدم وجود التتمة في نسخة الشهيد الأوّل
جاءت تعليقة للعلامة المجلسي في بعض نسخ كتاب (الإقبال)، من جملتها النسخة المرقمة 12374 في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي المدوّنة بتاريخ 1068 هجري([650])، وكانت بهذا التعبير:
«أقول: وجدت هذا الدعاء منقولاً من خطّ الشهيد محمّد بن مكّي قدس الله روحه إلى قوله: (وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ولم يكن ما بعده في تلك النسخة»([651]).
يفهم من عبارته (في تلك النسخة) أنّ هذه الزيادة موجودة في نسخ أخرى لدعاء عرفة.
هناك من ادّعى: أنّ العادة بين العلماء جرت على كتابتهم بعض التعليقات والملاحظات في هوامش وأطراف كتبهم ومع مرور الزمان تتدرج شيئاً فشيئاً إلى النصّ وذلك إثر التساهل فتنسب إلى مؤلف الكتاب أو تعدّ استمراراً لحديثه كما يُستفاد هذا من كلمات العلامة السابقة الذكر.
هذا الاحتمال ضعيف جدّاً، وذلك:
أوّلاً: لا ينسجم مع ما عليه العلماء من الاحتياط والدقّة في ضبط النسخ ومسائلها، وكحدٍ أدنى فإنّ الأصل هو عدم هذا الاحتمال إلّا في موضع ثبت فيه خلافه.
ثانياً: إن ذكرت معلومة في هوامش الكتاب فمع اسم الكاتب، وبخصوص تتمة دعاء عرفة لم يأت اسم ابن عطاء الله بتلك الصورة، وأثبتت التتمة في كتاب الإقبال باسم الإمام الحسين×.
ثالثاً: ما مدى التناسب بين تتمة دعاء عرفة ونفس الدعاء بحيث جاءا معاً؟
رابعاً: مقدار التتمة كبير جدّاً وليس لمثله أن يكتب في هامش.
هـ) أخذ الزيادة من بعض الصوفية
ادّعي: أنّ السيّد ابن طاووس أو آخرين قاموا بنقل الدعاء من بعض الصوفية وأوردوا الزيادة أيضاً، كما يدلّ على هذا الاحتمال كلام العلامة المجلسي أيضاً، حيث قال:
«... وعبارات هذه الورقة لا تلائم سياق أدعية السادة المعصومين أيضاً وإنّما هي على وفق مذاق الصوفية، ولذلك قد مال بعض الأفاضل إلى كون هذه الورقة من مزيدات بعض مشايخ الصوفية ومن إلحاقاته وإدخالاته.
وبالجملة، هذه الزيادة إمّا وقعت من بعضهم أوّلاً في بعض الكتب، وأخذ ابن طاووس عنه في (الإقبال) غفلة عن حقيقة الحال، أو وقعت ثانياً من بعضهم في نفس كتاب (الإقبال)، ولعل الثاني أظهر على ما أومأنا إليه من عدم وجدانها في بعض النسخ العتيقة وفي (مصباح الزائر)، والله أعلم بحقائق الأحوال»([652]).
وهذا الاستدلال مخدوش من عدّة جهات:
أوّلاً: هل أنّ أدعية أهل البيت^ قليلة حتّى احتيج إلى نقل أدعية الصوفية.
ثانياً: السيّد ابن طاووس ـ وبناء على نقل بعض العلماء ـ كان ملهماً إلى درجة أنّه ينشئ الأدعية، فما حاجته لذكر أدعية الصوفية.
ثالثاً: لو افترضنا أنّ السيّد ابن طاووس أو غيره قام بنقل تلك الزيادة عن الصوفية فلماذا لم يذكر اسمه في البداية حتّى لا يختلط مع غيره من الأدعية المشابهة له.
رابعاً: في أيّ كتاب من كتب أدعية السيّد ابن طاووس ـ بجلالة شأنه ومكانته ـ شوهد نقل لبعض أدعية عرفاء الصوفية حتّى يُدعى أنّ هذا واحد منها.
خامساً: إنّ شأن علمائنا أجل وأرفع من أن يجعلوا كلام عرفاء الصوفية السنّة بمصاف أدعية أهل بيت العصمة والطهارة^ ومقارنتها بها.
و) أخذ الزيادة من ابن عطاء اللّه الإسكندراني
يعتقد بعض أنّ المُنشئ الأوّل لهذا الدعاء ـ الزيادة ـ هو الصوفي ابن عطاء الله الإسكندراني المصري.
يبدو أنّ أوّل شخص شكك في نسبة هذه الزيادة للإمام الحسين× ونسبها لابن عطاء الله الإسكندراني هو جلال الدين همائي في كتابه: (مولوي نامه) حيث قال:
«هناك ملاحظة مهمّة جديدة لعلكم تسمعونها لأوّل مرة من هذا الحقير، وهي أنّي رأيت جميع هذه الفقرات بأعينها، ودون نقص أو زيادة في نسخة قديمة لكتاب (الحكم العطائية) المشتمل على الدعوات والمقامات العرفانية الخاصة بـ(ابن عطاء الله الإسكندراني الشاذلي)، وكتبها تاج الدين أبو الفضل أحمد بن محمّد الصوفي العارف المعروف في القرن السابع من الهجرة والذي كانت وفاته في 709 ﻫ ق، ومن المسلّم عندي وقوع خلط في الأمر، ولكن تفصيله خارج عن نطاق هذه التعليقات، والله العالم»([653]).
نعم، تأثر بعض علماء الشيعة برأي جلال الدين همائي، واتفقت كلمتهم على نسبة الزيادة لابن عطاء الله ومن بينهم العلامة محمّد حسين الحسيني الطهراني وآية الله الشبيري الزنجاني.
قال آية الله الشبيري الزنجاني:
«من الأعمال الصعبة جدّاً معرفة نص الحديث وتشخيص أنّ عباراته من الممكن نسبتها للمعصوم، وشخص مثل المرحوم المجلسي يمكنه إبداء رأيه في هذا المجال.
بما أنّ السيّد الخميني ممّن له باع بالعرفان وقد أدرك علو وسمو مضامين تتمة دعاء عرفة، صار معتقداً بأنّ هذه التتمة تعود لسيّد الشهداء× حتماً، وكان يقول: (إن أراد غير المعصوم أن ينشئ دعاء كهذا سيتلجلج لسانه ويتلعثم!).
ولكن علم فيما بعد أنّ هذه الزيادة من إنشاءات ابن عطاء الله الإسكندراني من كبار الصوفية في القرن السابع وأوائل القرن الثامن الذي كتبت شروح كثيرة لكتابه. وهذا ما ذكّر به المرحوم جلال همائي في كتابه (مولوي نامه). وصرح المرحوم المجلسي في (بحار الأنوار) أنّ هذه العبارة ليست من الأئمة وفيها سنخية مع كتابات الصوفية. وبالطبع إنّ المجلسي ليس لديه علم بالقائل، وما يعلمه أنّها للصوفية. والسيّد الخميني يعتقد بأنّها من المعصوم لمجرد سمو وعلو مضامينها»([654]).
أوّلاً: إنّ المجلسي بنفسه قد استشهد بفقرات من هذه الزيادة في بعض المواضع من كتابه الشريف (بحار الأنوار) وقد نسبها حينها إلى سيّد الشهداء×، وقد أشرنا إلى بعضها سابقاً.
ثانياً: نحن لم ننسب هذه الزيادة لسيّد الشهداء× فقط بدلالة سمو وعلو المضمون، وإنّما نرى من البعيد أخذ السيّد ابن طاووس هذا الدعاء من ابن عطاء الله الإسكندراني الصوفي السنّي.
ثالثاً: كيف من الممكن أن تقوم شخصية مقدّسة مثل السيّد ابن طاووس أو غيره ممن كتبوا تعليقات وهوامش على كتاب (الإقبال) أن ينسبوا أدعية المخالفين للمعصوم×، رغم أنّنا نجد هذه النسبة للإمام× قد جاءت في أكثر نسخ (الاقبال).
رابعاً: لم يذكر دليل على أنّ هذا الدعاء لابن عطاء الله سوى أنّه وجد في مخطوطاته، ومجرد وجوده في كتاب أحد الصوفية لا يعني أنّه هو من أنشأه؛ لأنّ العرفاء والصوفية عادة ما ينتفعون من أدعية الأئمة^ لعلو مضامينها، وينقلونها في كتبهم؛ وبهذا يصبح من الممكن ادعاء أنّ ابن عطاء الله قام بما قام به ذو النون المصري إذ نقل هذا الدعاء من المصادر الشيعية في كتبه حيث كان ملتزماً بقراءته، ثمّ جاء تلاميذه أو أصدقاؤه أو بسطاء الناس ونسبوه إليه، وأوردوه في كتبه.
خامساً: كيف يمكن ادعاء أنّ هذه الزيادة من إنشاء ابن عطاء الله وقام السيّد ابن طاووس بأخذها منه وأوردها في كتابه (الإقبال)، وقد وافته المنية في الخامس من ذي القعدة سنة 664([655]) ووفاة ابن عطاء الله في جمادى الآخرة سنة 709([656])، فمع هذه الفاصلة الزمنية بين وفاتيهما ـ والتي تبلغ 44 سنة وسبعة أشهر، أي ما يقرب من نصف قرن ـ كيف يمكن ادعاء ذلك؟!
و لهذا قال العلامة الطهراني:
«إنّ هذه الفقرات من الدعاء ذكرها العارف المشهور أحمد بن محمّد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري المتوفى سنة 709 هجريّة في كتابه المسمّى بـ(الحِكم العطائيّة والمناجاة الإلهيّة) حيث عُدّت من جملة أدعية هذا العارف ومناجاته. وكانت وفاة ابن طاووس على ما في (أعيان الشيعة) ج 42، ص 184، في سنة 664 هجريّة، فإذا صحّت نسبة هذا الدعاء إلى ابن عطاء فمن المستبعد أن ينقلها ابن طاووس في كتابه في حين أنّ ابن عطاء توفي بعد ابن طاووس بـ(45 سنة)، لذا فإنّ الاحتمال الثاني للمجلسي أرجح. ولكن يمكننا أن نقول: إنّ هذا الدعاء لسيّد الشهداء× نفسه بَيدَ أنّ ابن طاووس لم يعثر على هذه الفقرة عند تأليف (مصباح الزائر) وأوردها في (الإقبال)، ثمّ نقل ابن عطاء ـ وكان معاصراً لابن طاووس ومتأخّراً عنه ـ هذا الدعاء عن ابن طاووس وذلك في كتابه (الحكم) وكان يُناجي به، لذا عُدّ من مناجاته بعد وفاة ابن عطاء»([657]).
سادساً: لم يشاهد في أيّ نسخة من نسخ (الإقبال) التي وردت فيها هذه الزيادة ذكر لابن عطاء الله الإسكندراني.
سابعاً: لقد جاء عن الأستاذ الصدرائي الخوئي الخبير في نسخ الكتب الدينية:
«إنّ ذيل دعاء عرفة مثل دعاء عرفة موجود في أغلب نسخ (إقبال الأعمال)، ووجهة نظر المرحوم الشيخ عباس القمي التي بيّنها في (مفاتيح الجنان) صحيحة، حيث قال: ولكن زاد السيّد ابن طاووس في (الإقبال) بعد: (يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ) هذه الزيادة، وتكشف عن خبرة هذا الرجل الإلهي الواسعة في النسخ.
ولكن العثور على هذه الزيادة في كلمات ابن عطاء لا يشكل دليلاً على أنّها له؛ لأنّ ابن عطاء متأخر عن ابن طاووس هذا أوّلاً، وثانياً لم يأت في أية نسخة من نسخ (الإقبال) التي جاءت فيها تلك الزيادة ذكر لاسم ابن عطاء. إضافة إلى أنّه وطبقاً لبحوث الكرباسجي أنّ جانباً من فقرات دعاء عرفة ورد في كلمات ذي النون المصري أيضاً. فلا يمكننا أن نحكم بمجرد مجيء فقرات هذا الدعاء في كلمات شخص ما أنّ الدعاء له؛ إذ يستخدم العرفاء والمفكرون عادة كلمات الأئمة^ نظراً لما تتضمّنه من معاني رفيعة. فمن الأفضل أن نقول: إنّ ابن عطاء مثل ذي النون قد أخذ هذا الدعاء عن المصادر الشيعية، لا أن نتهم علماء الشيعة بأخذهم كلمات ابن عطاء ثمّ نسبتها للإمام»([658]).
وقال أيضاً في موضع آخر خلال مقابلة معه من قبل موقع (شفقنا) الإلكتروني:
«إنّ هذا البحث الذي بيّنه الشيخ عباس القمي تحت عنوان ذيل دعاء عرفة، حيث يقطع الدعاء بحسب رأيه بعدما يكتمل الدعاء بعبارة (يَا رَبِّ يَا رَبِّ). ويذكر المرحوم القمي إضافة قام المرحوم ابن طاووس بنقلها في كتاب (إقبال الأعمال). ولكن هذه الزيادة لم يأت بها المرحوم الكفعمي والعلامة المجلسي في نقليهما. ولهذا السبب اشتعل أوار البحث في مجال الدراسات حول الأدعية في العشر السنوات الأخيرة تقريباً في كونه وارداً أم لا؟ ما يؤسف له أنّها قد حذفت من بعض كتب (إقبال الأعمال) أيضاً مع أنّه ليس فنياً إطلاقاً وليس عملاً أكاديمياً، فحتّى لو ورد في نسخة واحدة كان على المصحح أن يأت بها على الأقل في النقل من النسخ. ونشأت هذه الشبهة أساساً من العبارة التي بدأ بها هذه الزيادة، وهي (إِلَهِي أَنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَايَ...)، وحيث وجدت هذه الزيادة في كتاب باسم (الحكم العطائية) لابن عطاء الإسكندراني، بمعنى أنّها نقلت في آخر الكتاب، وهذا ما دفع جماعة ليظنّوا عدم رجوعها للإمام× من الأساس وأنّها نقلت من ذلك الكتاب.
ولدفع هذه الشبهة أمرت أحد الجامعيين قبل عدّة سنوات أن يكتب أطروحة حول هذه المسألة، وهي أنّ تكملة دعاء عرفة هل هي جزء من هذا الدعاء وتتناسب معه من حيث المحتوى العلمي والمضمون أو لا؟
وقام بطرح عدّة أسئلة كان أحدها: هل أنّ هذه الزيادة بلحاظ المحتوى تباين نفس الدعاء؟ بمعنى أنّها بذلك اللحاظ تختلف عن دعاء عرفة؟ وهل يمكننا القول بأنّها جزء من الدعاء أو لا؟ وقد خرج بنتيجة مفادها أنّنا إن قبلنا دعاء عرفة فلا يوجد اختلاف بينهما من ناحية المضمون، بل التكملة متطابقة مع الدعاء بشكل كامل. وكان لديه بحث آخر في معرفة النسخ حيث راجع جميع النسخ المعروفة لكتاب (إقبال الأعمال) والتي كان عددها حتّى ذلك الوقت 46 نسخة في المكتبات الشيعية. وقدّم تقريراً عن تلك النسخ بهذه الصورة وهي أنّه قد ورد الدعاء ومعه هذه الزيادة في 25نسخة من أصل 46 نسخة دون أن يكون بينهما فاصلة، وجاءت الزيادة متصلة مع الدعاء بشكل كامل. وهذا يعني أنّ 60 بالمائة من نسخ (إقبال الأعمال) جاءت الزيادة فيها متصلة مع الدعاء. وفي البقية، أي بحدود 5ـ6 نسخ جاء فيها الدعاء والزيادة ولكنها جاءت في الهامش. وفي بعضها، أي بحدود 5ـ6 نسخ جاء الدعاء بدون الزيادة، ووفقاً لهذا المعطى لا يمكن الاعتماد على هذه 5ـ6 نسخ. وفي نهاية دراسته توصل إلى النتيجة التي توصل لها الشيخ عباس القمي وهي أنّ دقة الشيخ أوصلته إلى التسليم بوجود الزيادة، وأنّه بحث وتأمل ولاحظ جميع النسخ. وعندما يكون ابن طاووس أوّل شخص ينقلها فلم يكن عندها من داع للتغافل وعدم ذكرها.
وأيضاً الشخص العزيز الذي طرح هذه الإشكالية أشار إلى أنّ هذه الزيادة تعود لابن عطاء الإسكندراني. وهنا يجب علينا الالتفات إلى أنّ ابن عطاء متوفى في سنة 709 للهجرة فكيف يمكن أن ينقل عنه ابن طاووس في كتابه؟! هذا مع أنّ ابن طاووس كان دقيقاً إلى درجة أنّه يذكر في بعض الملاحظات حتّى النسخ التي نقل عنها. كأن يقول هذا الكتاب للمؤلف الفلاني، وقد رأيته في مكتبة بغداد في الكتاب الفلاني، فكيف لم يذكر في كتابه الإقبال أنّه جاء بهذه الزيادة من كتاب لابن عطاء ولا حتّى في نسخة واحدة من نسخه، ولو في آخر الكتاب. وما يلزمنا العلم به أنّ ما كان مشهوراً هو أنّ المؤلف إذا نقل مطلباً عن عالم لديه علاقة به يذكره في آخر كتابه لا لغاية سوى النقل. وهنا تنشأ شبهة وهي أنّ هذا النقل من إنشائه نفسه. وما أورده من إشكال على هذه الزيادة أنّها لم ترد في (إقبال الأعمال) فقط، وهو مرتفع إذ إنّها قد وردت في 60 بالمائة من نسخ هذا الكتاب، وجاءت حتّى من دون فاصلة. وقطع الشيخ عباس أيضاً بوجود الزيادة؛ وعليه فلا وجه للاعتقاد بانفصالها»([659]).
وتابع كلامه قائلاً:
«إن لم يقرأ شخص هذه الزيادة فإنّه لم يقرأ الدعاء بشكل كامل، ومنشأ هذا الإشكال من تصحيح لـ(إقبال الأعمال) طبع بواسطة إحدى دور النشر في قم؛ حيث لم يراع المصحح الأمانة العلمية، فمثلاً إن راجع عشر نسخ وكانت الزيادة في خمس منها فيجب على الأقل أن يأتي بها في الهامش، ولكن للأسف حذفها من النص والهامش معاً.
والمؤسف أنّ الدعاء يقرأ لسنوات طويلة دون الزيادة في أكثر المناسبات، وفي تلك الحال الدعاء يقرأ ناقصاً مما أقلق العلماء. فعندما يقول الشيخ عباس القمي: إنّ ابن طاووس أورد الدعاء بهذه الصورة يجب أن نعمل به.
وبحسب رأيي أنّ الادعاء المطروح غير ثابت ولا مقبول بحسب المعايير العلمية في النسخ والكتب»([660]).
ثامناً: بما أنّ الصوفية من أهل السنّة لديهم مقدار من الإنصاف والاهتمام الخاص بأهل البيت^ نجدهم ينتفعون بالأدعية المنسوبة لهم^ ويدوّنونها ويقرؤونها، إلّا أنّ تلاميذهم ظنّوا أنّها من إنشاء شيوخهم.
ويشهد على هذه الدعوى ما قام به ذو النون المصري المتوفى سنة 246 هجرية من الصوفية المالكيين، حيث استشهد بفقرات من دعاء عرفة في أدعيته.
نشير هنا إلى بعض الفقرات من أدعيته والموجودة في دعاء عرفة أيضاً:
قال أبو نعيم الإصفهاني:
«حدثنا أبو عبد الله محمّد بن إبراهيم، حدثني أحمد بن محمّد بن حمدان النيسابوري أبو حامد، ثنا عبد القدوس بن عبد الرحمن الشامي، قال: سمعت أبا الفيض ذا النون ابن إبراهيم المصري يقول: إلهي وسيلتي إليك نعمك علي، وشفيعي إليك إحسانك إلي، إلهي أدعوك في الملأ كما تدعى الأرباب، وأدعوك في الخلا كما تدعى الأحباب، أقول في الملأ: يا إلهي، وأقول في الخلا: يا حبيبي، أرغب إليك وأشهد لك بالربوبية مقراً بأنّك ربي وإليك مردي، ابتدأتني برحمتك من قبل أن أكون شيئاً مذكوراً، وخلقتني من تراب ثمّ أسكنتني الأصلاب، ونقلتني إلى الأرحام، ولم تخرجني برأفتك في دولة أيمة ثمّ أنشأت خلقي من مني يمنى، ثمّ أسكنتني في ظلمات ثلاث بين دم ولحم ملتاث، وكونتني في غير صورة الإناث، ثمّ نشرتني إلى الدنيا تاماً سوياً، وحفظتني في المهد طفلاً صغيراً صبياً، ورزقتني من الغذاء لبناً مرياً، وكفلتني حجور الأمهات، وأسكنت قلوبهم رقة لي وشفقة علي، وربيتني بأحسن تربية، ودبرتني بأحسن تدبير، وكلأتني من طوارق الجن وسلمتني من شياطين الإنس، وصنتني من زيادة في بدني تشينني، ومن نقص فيه يعيبني، فتباركت ربي وتعاليت يا رحيم، فلما استهللت بالكلام أتممت علي سوابغ الإنعام، وأنبتني زائداً في كل عام، فتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، حتّى إذا ملكتني شأني وشددت أركاني أكملت لي عقلي، ورفعت حجاب الغفلة عن قلبي، وألهمتني النظر في عجيب صنائعك وبدائع عجائبك، وأوضحت لي حجتك ودللتني على نفسك، وعرفتني ما جاءت به رسلك، ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم وإحسانك القديم، وجعلتني سوياً ثمّ لم ترض لي بنعمة واحدة دون أن أتممت علي جميع النعم، وصرفت عنّي كل بلوى، وأعلمتني الفجور لأجتنبه، والتقوى لأقترفها، وأرشدتني إلى ما يقربني إليك زلفى، فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن حمدتك شكرتني، وإن شكرتك زودتني. إلهي فأيّ نعم أحصي عدداً، وأيّ عطائك أقوم بشكره، أما أسبغت علي من النعماء أو صرفت عنّي من الضراء. إلهي أشهد لك بما شهد لك باطني وظاهري وأركاني، إلهي إنّي لا أطيق إحصاء نعمك فكيف أطيق شكرك عليها، وقد قلت وقولك الحق:(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا)([661]) أم كيف يستغرق شكري نعمك وشكرك من أعظم النعم عندي، وأنت المنعم به علي كما قلت سيّدي:(وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ)([662]) وقد صدقت قولك. إلهي وسيّدي، بلغت رسلك بما أنزلت إليهم من وحيك غير أنّي أقول بجهدي ومنتهى علمي ومجهود وسعي ومبلغ طاقتي: الحمد لله على جميع إحسانه حمداً يعدل حمد الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين»([663]).
وبخصوص الزيادة في دعاء عرفها والتي جاءت في كتاب (الحكم العطائية) من الممكن تسرية الحكم إليها ونقول: إنّ ابن عطاء الله الإسكندراني قد عثر على هذه الزيادة التي هي من إنشاء الامام الحسين× في مصادر الشيعة، وأخذ يقرأها، ومن ثمّ وجدها تلاميذه في مدوّناته، ورأوا من المناسب الإتيان بها في كتاب (الحكم العطائية)، ولما كانت غير منسجمة مع حكم الكتاب جاؤوا بها في آخره وتحت عنوان مستقل هو (مناجاة)، وفصلوها في الترقيم عما قبلها، ولذا ابتدأ ابن عجيبة الحسني شرحه لهذه المناجاة بقوله:
«وهاهنا انتهى الكتاب، وما بقي إلّا مناجاة الكريم الوهاب...»([664]).
ويقول آية الله سعادت پرور بهذا الخصوص:
«لا يخفى أنّ الشراح لرسالة الحكم ينسبون تلك الكلمات له، وفي آخر الشرح أيضاً ينقلون عنه رسائل لإرشاد السالكين وأيضاً الزيادة في دعاء عرفة لسيّد الشهداء×، وبنفس الطريقة التي شرحوا بها الكلمات والرسائل شرحوا ووضحوا هذه الزيادة أيضاً، ولكنهم ترددوا أنّ هذا الدعاء له أو لا؛ فمنهم من ادعى أنّه له، ومنهم من يرى أنّه فقط كان يقرأ هذا الدعاء.
أمّا من كان له معرفة بكلمات وأدعية المعصومين^ سيقطع بأنّ هذه الزيادة لا تصدر إلّا من المعصوم الذي له إشراف وشهود على الذات والأسماء والكمالات الإلهية، كما أنّ رأي أستاذنا [العلامة الطباطبائي&] كان هذا أيضاً. وصاحب الحِكم أيضاً قد اختار هذا الدعاء لمضامينه العالية من إقبال السيّد ـ رحمة الله عليه ـ وأخذ يقرأه. وإلّا فإنّ مجرد عدم وجود هذا القسم من الدعاء في بعض كتب المحدثين الآخرين لا يعدّ دليلاً على كونه من إضافات صاحب الحكم أو غيره، وما أكثر وقوع هذا النحو من الزيادة والنقيصة في المنقول الروائي والدعائي، ويبقى هذا السؤال قائماً، هل من الممكن تطبيق هذه الكلمات التي تتلى في هذا الدعاء؟ فمن المناسب واللائق بالكتّاب والمحققين التدقيق أكثر في أقوالهم وآرائهم»([665]).
ويشهد على كلامه عدم الإتيان بهذه المناجاة من قبل بعض شراح كتاب (الحكم العطائية)، وتبعاً لذلك لم يشرحوها مثل محمّد باسم الدهمان في شرحه الموسوم بـ(أذواق النقشبندية في شرح الحكم العطائية).
ومن الممكن الاستفادة من كلام الشيخ عبد الله الشرقاوي الذي جاء في شرحه لهذه الزيادة حيث لا يقطع بنسبتها لابن عطاء الله الإسكندراني، ولهذا عبر قائلاً:
«وفي بعض النسخ: ومن مناجاته: (إِلَهِي أَنَا الْفَقِيرُ فِي)...»([666]).
فقال آية الله سعادت پرور:
«ظنّ بعض العلماء أنّ هذا الدعاء من (إِلهِي أَنَا الْفَقِيرُ...) حتّى (الحمْدُ للهِ وَحْدَهُ) إضافة من قبل بعض أهل الكمال قاموا بإلحاقه بالدعاء؛ وذلك لعدم وجوده في بعض كتب السيّد& وغيره، لكن هذا الظن لا يمكن قبوله؛ لأنّ التحقيق والتأمل في مضامين كلمات المعصومين^ وأدعيتهم يثبت خلاف ذلك، كما كان مضمون كلام أستاذنا العلامة الطباطبائي& (المطلع بصورة كاملة على الكتاب والسنّة وله منزلته ومكانته الرفيعة في الفلسفة والعرفان العلمي والعملي) بهذا الخصوص هو: (أنّ أدعية المعصومين^ تصرخ بلا سند أنّنا خرجنا من حناجر لا يقدر أيّ فيلسوف أو عارف أن يقول مثلها، وذلك في مرحلة الشهود أيضاً لا الاستدلال)، وقال بخصوص ذيل دعاء عرفة: (كان ممتلئاً بالمعلومات إلى درجة يكاد ينفجر). فمن اللائق بأهل البحث والتحقيق في أدعية المعصومين^ الانتباه إلى أنّ عبارات هذا القسم موجودة في أدعية المعصومين^ الأخرى، وهذا بنفسه يعدّ شاهداً على صحة نسبته لسيّد الشهداء× من قبل صاحب (إقبال الأعمال).
من الأدعية التي تشتمل على جمل شبيهة لتتمة دعاء عرفة هو الدعاء الذي علّمه أمير المؤمنين× لنوف. ومن المناسب أن يلاحظ القرّاء الأعزاء ذلك ويستنتجوه من خلال ما قدمناه من تفسير وبيان في شرحنا له، والحمد لله»([667]).
وهنا نذكر هذا الدعاء بصورة كاملة حتّى يحكم القراء بأنفسهم:
قال نوف البكالي:
«رَأَيْتُ أَمِيرَ المؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مُوَلِّياً مُبَادِراً، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا مَوْلَايَ؟ فَقَالَ: دَعْنِي يَا نَوْفُ، إِنَّ آمَالِي تُقَدِّمُنِي فِي المحْبُوبِ. فَقُلْتُ: يَا مَوْلَايَ، وَمَا آمَالُكَ؟ قَالَ: قَدْ عَلِمَهَا المأْمُولُ، وَاسْتَغْنَيْتُ عَنْ تَبْيِينِهَا لِغَيْرِهِ، وَكَفَى بِالْعَبْدِ أَدَباً أَنْ لَا يُشْرِكَ فِي نِعَمِهِ وَإِرَبِهِ غَيْرَ رَبِّهِ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المؤْمِنِينَ، إِنِّي خَائِفٌ عَلَى نَفْسِي مِنَ الشَّرَهِ وَالتَّطَلُّعِ إِلَى طَمَعٍ مِنْ أَطْمَاعِ الدُّنْيَا. فَقَالَ لِي: وَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ عِصْمَةِ الخائِفِينَ وَكَهْفِ الْعَارِفِينَ؟! فَقُلْتُ: دُلَّنِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تَصِلُ أَمَلَكَ بِحُسْنِ تَفَضُّلِهِ، وَتُقْبِلُ عَلَيْهِ بِهَمِّكَ، وَأَعْرِضْ عَنِ النَّازِلَةِ فِي قَلْبِكَ، فَإِنْ أَجَّلَكَ بِهَا فَأَنَا الضَّامِنُ مِنْ مُورِدِهَا، وَانْقَطِعْ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُقَطِّعَنَّ أَمَلَ كُلِّ مَنْ يُؤَمِّلُ غَيْرِي بِالْيَأْسِ، وَلَأَكْسُوَنَّهُ ثَوْبَ المذَلَّةِ فِي النَّاسِ، وَلَأُبْعِدَنَّهُ مِنْ قُرْبِي، وَلَأُقَطِّعَنَّهُ عَنْ وَصْلِي...
ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ السَّلَامُ لِي: يَا نَوْفُ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ:
إِلَهِي، إِنْ حَمِدْتُكَ فَبِمَوَاهِبِكَ، وَإِنْ مَجَّدْتُكَ فَبِمُرَادِكَ، وَإِنْ قَدَّسْتُكَ فَبِقُوَّتِكَ، وَإِنْ هَلَلْتُكَ فَبِقُدْرَتِكَ، وَإِنْ نَظَرْتُ فَإِلَى رَحْمَتِكَ، وَإِنْ عَضَضْتُ فَعَلَى نِعْمَتِكَ. إِلَهِي، إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَشْغَلْهُ الْوُلُوعُ بِذِكْرِكَ وَلَمْ يَزْوِهِ السَّفَرُ بِقُرْبِكَ كَانَتْ حَيَاتُهُ عَلَيْهِ مِيتَةً، وَمِيتَتُهُ عَلَيْهِ حَسْرَةً. إِلَهِي، تَنَاهَتْ أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ إِلَيْكَ بِسَرَائِرِ الْقُلُوبِ، وَطَالَعَتْ أَصْغَى السَّامِعِينَ لَكَ نَجِيَّاتِ الصُّدُورِ، فَلَمْ يَلْقَ أَبْصَارَهُمْ رَدٌّ دُونَ مَا يُرِيدُونَ، هَتَكْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ حُجُبَ الْغَفْلَةِ، فَسَكَنُوا فِي نُورِكَ، وَتَنَفَّسُوا بِرَوْحِكَ، فَصَارَتْ قُلُوبُهُمْ مَغَارِساً لِهَيْبَتِكَ، وَأَبْصَارُهُمْ مَآكِفاً لِقُدْرَتِكَ، وَقَرَّبْتَ أَرْوَاحَهُمْ مِنْ قُدْسِكَ، فَجَالَسُوا اسْمَكَ بِوَقَارِ المجَالَسَةِ، وَخُضُوعِ المخَاطَبَةِ، فَأَقْبَلْتَ إِلَيْهِمْ إِقْبَالَ الشَّفِيقِ، وَأَنْصَتَّ لَهُمْ إِنْصَاتَ الرَّفِيقِ، وَأَجَبْتَهُمْ إِجَابَاتِ الْأَحِبَّاءِ، وَنَاجَيْتَهُمْ مُنَاجَاةَ الْأَخِلَّاءِ، فَبَلِّغْ بِيَ المحَلَّ الَّذِي إِلَيْهِ وَصَلُوا، وَانْقُلْنِي مِنْ ذِكْرِي إِلَى ذِكْرِكَ، وَلَا تَتْرُكْ بَيْنِي وَبَيْنَ مَلَكُوتِ عِزِّكَ بَاباً إِلَّا فَتَحْتَهُ، وَلَا حِجَاباً مِنْ حُجُبِ الْغَفْلَةِ إِلَّا هَتَكْتَهُ، حَتَّى تُقِيمَ رُوحِي بَيْنَ ضِيَاءِ عَرْشِكَ، وَتَجْعَلَ لَهَا مَقَاماً نُصْبَ نُورِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِلَهِي، مَا أَوْحَشَ طَرِيقاً لَا يَكُونُ رَفِيقِي فِيهِ أَمَلِي فِيكَ! وَأَبْعَدَ سَفَراً لَا يَكُونُ رَجَائِي مِنْهُ دَلِيلِي مِنْكَ! خَابَ مَنِ اعْتَصَمَ بِحَبْلِ غَيْرِكَ، وَضَعُفَ رُكْنُ مَنِ اسْتَنَدَ إِلَى غَيْرِ رُكْنِكَ. فَيَا مُعَلِّمَ مُؤَمِّلِيهِ الْأَمَلَ فَيُذْهِبُ عَنْهُمْ كَآبَةَ الْوَجَلِ لَا تَحْرِمْنِي صَالِحَ الْعَمَلِ، وَاكْلَأْنِي كِلَاءَةَ مَنْ فَارَقَتْهُ الْحِيَلُ، فَكَيْفَ يَلْحَقُ مُؤَمِّلِيكَ ذُلُّ الْفَقْرِ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ عَنْ مَضَارِّ المذْنِبِينَ؟! إِلَهِي، وَإِنَّ كُلَّ حَلَاوَةٍ مُنْقَطِعَةٌ وَحَلَاوَةَ الْإِيمَانِ تَزْدَادُ حَلَاوَتُهَا اتِّصَالًا بِكَ. إِلَهِي، وَإِنَّ قَلْبِي قَدْ بَسَطَ أَمَلَهُ فِيكَ، فَأَذِقْهُ مِنْ حَلَاوَةِ بَسْطِكَ إِيَّاهُ الْبُلُوغَ لِمَا أَمَّلَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِلَهِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ مَنْ يَعْرِفُكَ كُنْهَ مَعْرِفَتِكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْلُكَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَفِتْنَةٍ أَعَذْتَ بِهَا أَحِبَّاءَكَ مِنْ خَلْقِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِلَهِي، أَسْأَلُكَ مَسْأَلَةَ الْمِسْكِينِ الَّذِي قَدْ تَحَيَّرَ فِي رَجَاهُ فَلَا يَجِدُ مَلْجَأً وَلَا مَسْنَداً يَصِلُ بِهِ إِلَيْكَ وَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَيْكَ إِلَّا بِكَ، وَبِأَرْكَانِكَ وَمَقَامَاتِكَ الَّتِي لَا تَعْطِيلَ لَهَا مِنْكَ، فَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي ظَهَرْتَ بِهِ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِكَ فَوَحَّدُوكَ، وَعَرَفُوكَ فَعَبَدُوكَ بِحَقِيقَتِكَ، أَنْ تُعَرِّفَنِي نَفْسَكَ؛ لِأُقِرَّ لَكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ عَلَى حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ بِكَ، وَلَا تَجْعَلْنِي يَا إِلَهِي مِمَّنْ يَعْبُدُ الِاسْمَ دُونَ المعْنَى. وَالحظْنِي بِلَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِكَ تَنَوَّرْ بِهَا قَلْبِي بِمَعْرِفَتِكَ خَاصَّةً وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»([668]).
ز) عدم انسجام الزيادة مع الأدعية الأخرى
ادّعي أنّ هذه الزيادة لا تنسجم مع أدعية أئمة أهل البيت^ الأخرى.
وهذا الإشكال قد جاء في كلام العلامة المجلسي.
أوّلاً: لعل منشأ كلام هذا المحدث الشيعي الكبير، ناظر إلى أنّ بعض فقرات الدعاء ـ بحسب رأيه ـ مخالفة لأحاديث أخرى لأهل البيت^، لكن لا يجب أن نتوقع وحدة سياق الأدعية مع سياق جميع الروايات، إذ قليلاً ما نجد اللطائف العرفانية والمقامات الشهودية للأدعية في الروايات؛ لأنّ الناس هم المخاطبون بالروايات، والمعصومون يتعاملون معهم ويتحدثون إليهم بمستوى عقولهم وفهمهم وإدراكهم ومعرفتهم لا أنّهم يقولون كل ما بلغت كنه عقولهم.
وروى الكليني في الكافي عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«مَا كَلَّمَ رَسُولُ اللهِ| الْعِبَادَ بِكُنْهِ عَقْلِهِ قَطُّ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ|: إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ»([669]).
وقال آية الله حسن زادة الآملي في ذلك:
«إنّ الأدعية المأثورة كل منها تمثل مقاماً من مقامات أئمة الدين الإنشائية والعلمية، وما تتضمّنه الأدعية من لطائف عشقية وعرفانية ومقامات ذوقية وشهودية لا توجد ولا تلحظ في الروايات؛ لأنّ المخاطب بالروايات هم الناس ويحاورنهم^ ويتحدثون إليهم بمستوى عقولهم وفهمهم وإدراكهم ومعرفتهم، لا بكنه معرفتهم وما طالته عقولهم...
أمّا في أدعيتهم ومناجاتهم فإنّهم يتوسلون بالجمال والجلال والحسن المطلق والمحبوب والمعشوق الحقيقي، لهذا يناجون ربهم متأدبين بما اكتنفته خزائن السر وأروقة العشق والبيت المعمور فيدعون ويناجون بكنه عقولهم»([670]).
وعليه لا يجب التشكيك والتردد بنسبة الأدعية للمعصومين^ وصدورها عنهم بمجرد عدم الانسجام الظاهري لبعض تلك الأدعية مع الروايات، بل إنّ هذا التردد يجب أن يوجه إلى مستندها ووثاقة الرواة، والرجوع إلى الأبحاث الدقيقة في علم اللغة، ومتى ما لوحظ عدم الانسجام مع الآيات القرآنية ففي هذه الحالة أيضاً يجب اللجوء إلى تأويل الآيات القرآنية ورفع اليد عن الظاهر أو التشكيك في سند الحديث المنسوب للمعصوم أو في دلالته، ومتى ما لوحظ عدم الانسجام مع العقل ففي هذه الصورة أيضاً يجب إعمال الدقة بشكل أكبر في الأدلة العقلية، فإن كانت تتعارض مع حكم العقل الصريح فلا بدّ من إعادة النظر في السند أو الدلالة.
ثانياً: إنّ محتوى هذا القسم من الدعاء لا يقف عند حدود عدم الانسجام مع سياق أدعية المعصومين^، بل على العكس فهو فضلاً عن وجود عبارات شبيهة لعباراته في أدعية وأحاديث المعصومين، ينسجم مع آيات القرآن الكريم أيضاً مع عدم مخالفة الأدلة العقلية لما فيه أيضاً. ومن الممكن أن يشكل هذا القسم من دعاء عرفة أوج ظهور الحالة العرفانية لسيّد الشهداء× بالله تعالى وارتباط الوجود بالله ونحو حضور الله في الوجود، وكيفية تعرف المخلوقات إليه.
وأفضل شاهد ونظير على ذلك ما جاء في بعض فقرات المناجاة الشعبانية، حيث جاء فيها:
«إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَ الِانْقِطَاعِ إِلَيْكَ، وَأَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ، حَتَّى تَخِرَقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فَتَصِلَ إِلَى مَعْدِنِ الْعَظَمَةِ، وَتَصِيرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ. إِلَهِي، وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ نَادَيْتَهُ فَأَجَابَكَ، وَلَاحَظْتَهُ فَصَعِقَ لِجَلَالِكَ، فَنَاجَيْتَهُ سِرّاً وَعَمِلَ لَكَ جَهْراً»([671]).
ثالثاً: ما الإشكال في أن يكون محتوى القسم الأوّل من دعاء عرفة عاماً، أمّا قمة المعارف فقد جاءت في الأقسام الختامية؟ فهل هذا المقدار من الاختلاف دليل عدم التوافق؟!
رابعاً: نحن وإن لم ننكر صدور كلمات عالية المضامين من غير المعصومين^، ولكننا نعتقد أنّ الكلام أحياناً بلحاظ التعبير أو المحتوى قد يبلغ القمة فيهما بحيث يصبح صدوره عن غير المعصوم من المحالات العادية، كما أنّ أقوى دليل على قطعية صدور القرآن الكريم علو مضمونه وإعجازه المعنوي واللفظي.
والروايات أيضاً تأتي في مرتبة أدنى من القرآن، ولهذا يعتقد ابن أبي الحديد بأنّ نهج البلاغة مسلّم الصدور للقرائن المضمونية التي اشتمل عليها، وينتقد المشككين في ذلك ([672]).
وممن يسلم بصدور القسم الثاني لدعاء عرفة عن سيّد الشهداء× العلامة السيّد حسين الهمداني الدرودآبادي، حيث يقول:
«وإلى هذا أشار مولانا أبو عبد الله الحسين× في دعاء عرفة: (إِلَهِي... كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ؟! أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المظْهِرَ لَكَ؟! مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ؟! وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ؟! عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيباً)»([673]).
وقال أيضاً في موضع آخر:
«قال مولانا أبو عبد الله الحسين× في دعاء عرفة: (إِلَهِي أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْآثَارِ، فَأَرْجِعْنِي إِلَيْكَ بِكِسْوَةِ الْأَنْوَارِ، وَهِدَايَةِ الِاسْتِبْصَارِ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ مِنْهَا، كَمَا دَخَلْتُ إِلَيْكَ مِنْهَا، مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَمَرْفُوعَ الْهِمَّةِ عَنِ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهَا، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)»([674]).
والقاضي سعيد القمي هو الآخر يسلم بصدوره عن الإمام الحسين× لذا يقول في شرحه لتوحيد الصدوق:
«وأمّا العارفون بنور الله عزّ شأنه، الفائزون بـ(المحبوبيّة التّامة) فيقولون كما ورد في دعاء عرفة عن سيّد الشّهداء ـ عليه ألف سلام وتحيّة وثناء ـ: كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ؟! أَلِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المظْهِرَ لَكَ؟!»([675]).
وقال آية الله الجوادي الآملي:
«إنّ الأصل عند دراسة سند الروايات، وما له موضوعية في ذلك هو صدورها عن الإمام المعصوم، وهذا يعني أنّ الباحث الروائي يجب أن يحصل على الاطمئنان بأنّ هذا المحتوى المبحوث صادر عن المعصوم×، وهذا الاطمئنان يحصل أحياناً عن طريق وثاقة الراوي وصدقه، وأحياناً من خلال سمو المضمون وإتقان النص، وأحياناً عن طريق الشواهد والقرائن المنفصلة والمتصلة، لهذا يهتمّ بدراسة سند الأحاديث بما أنّها طريق لتحصيل الاطمئنان، وبعبارة اصطلاحية ليس له موضوعية بل طريقية»([676]).
ثمّ يذكر مجموعة من الشواهد والقرائن في تتمة كلامه لإثبات أنّ ذيل دعاء عرفة صادر عن الإمام الحسين×، وهي:
«1ـ إنّ السيّد ابن طاووس+ من عظماء الإمامية، وقد نقله في كتابه القيّم (إقبال الأعمال)، وليس هناك من خدشة في نقله وإن خلت منه بعض النسخ المخطوطة لهذا الكتاب نتيجة نسيان بعض النساخ، وقد قال الأستاذ الكبير المرحوم العلامة الشعراني: (عثرت وخلال بحثي في مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة نسخة قديمة ومعتبرة لكتاب (إقبال الأعمال) وقد جاء فيها ذيل الدعاء).
2ـ المحتوى الرفيع لهذا الدعاء النوراني علامة على صدور هذا النص من لسان المعصوم×.
3ـ القسم الأوّل من دعاء عرفة الشريف تضمّن محتوى عاماً، الطلب من الله، وعرض المصاعب والمشكلات بين يدي الذات الإلهية المقدّسة، وطلب الحوائج العلمية والعينية منه و... وهذه منتشرة في جميع الأدعية أيضاً، ولكن سلطان مطالب دعاء عرفة وقمة معارفه وأرفعها جاءت في الأقسام الأخيرة منه التي تضاهي من حيث المحتوى كلمات الإمام الحسين× الأخرى»([677]).
وقال الإمام الخميني حول ذلك في كتابه (مصباح الهداية):
«قال مولانا أبو عبد الله الحسين× في دعاء (عرفة): (أَلِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ؟!) صدق وليّ الله، وروحي له الفداء»([678]).
الملّا محسن الفيض الكاشاني أيضاً عدّ صدور القسم الثاني من دعاء عرفة عن الإمام الحسين× من المسلّمات، وقال في كتاب (الحقائق):
«وقال ابنه الحسين سيّد الشّهداء: (كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ؟! أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المظْهِرَ لَكَ؟! مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ؟! وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ؟! عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ وَلَا تَزَالُ عَلَيْهَا رَقِيباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيباً)»([679]).
والملا مهدي النراقي أيضاً يرى أنّ نسبة هذا الدعاء لسيّد الشهداء× من المسلّمات، وقال في أحد كتبه:
«كما قال سيّد الشهداء× في دعاء عرفة بقوله: (وَأَنْتَ الَّذِي أَزَلْتَ الْأَغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أَحِبَّائِكَ حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ، وَلَمْ يَلْجَؤوا إِلَى غَيْرِكَ)»([680]).
وقال محمّد الريشهري:
«فإنّه يشكل نسبة هذا المقطع إلى الإمام×، إلّا إذا حصل الاطمئنان بصدوره من المعصوم لقوّة مضامينه، كما نقل لي ذلك العالم الربّاني الشيخ علي سعادت پرور (بهلواني) رضوان الله تعالى عليه عن العلّامة السيّد محمّد حسين الطباطبائي، حيث قال: (من الّذي يقدر على بيان مثل هذه الحقائق؟! لقد اشتغلنا عمراً في المسائل الفلسفية والعرفانية ونحن نعجز عن مثل هذا الكلام!)»([681]).
خامساً: إنّ وجود مشكلة في عدّة أسطر أو عدّة صفحات في دعاء مّا لا يعدّ دليلاً على وضع الدعاء بأكمله وإسقاطه عن الاعتبار. أنت لا تقبل هذه الأسطر ولكن ما تبقى من الدعاء يظل على مكانته، وهذا مثل من يريد أن يجعل عدم صحة القسم الأخير من دعاء عرفة لرد الدعاء بأكمله، وهذا ليس صحيحاً. ولو كان في نفس هذا القسم 13 جملة فرضاً فيها مشكلة، فلا يعني ذلك أن تردّ هذا القسم المؤلف من 57 جملة تقريباً.
سادساً: إنّ جميع هذه الجمل أو أكثرها لا تشتمل على إشكال ومفاهيمها صحيحة، فمثلاً جملة: «إِلَهِي أَمَرْتَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْآثَارِ»ما المشكلة فيها؟ وما الدليل على عدم اتساقها مع عبارات المعصومين^؟! إنّ الإمام يخاطب الله تعالى بأنّك أمرت بالرجوع إلى الآثار ومن خلال التأمّل فيها نتعرّف إليك. أحد الطرق لمعرفة الله هو الرجوع إلى الآثار والاستدلال بها عليه، وهذا المسلك عام وللعموم صحيح ومعقول، وليس هناك من ينكر هذا المسلك، رغم أنّه جاء أيضاً ذكر مسالك وطرق أفضل في بعض سطور القسم الأخير من الدعاء لمعرفة الله الحضورية والشهودية.
سابعاً: لو افترضنا وجود إشكال في بعض فقرات هذا الدعاء، فإنّها قابلة للتأويل والتوجيه، إذ لم تبلغ إلى درجة مقطوعية البطلان، وفي هكذا حالات يكون باب التأويل مفتوحاً، ويبطل ادّعاء عدم الصدور والحكم بالجعل من الأساس.
ح) الإشارة فيه إلى وحدة الوجود
من بين الإشكالات على محتوى ذيل دعاء عرفة، وجود بعض التعبيرات التي تشير لمسألة وحدة الوجود، مثلاً: حيث يقول:
«أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المظْهِرَ لَكَ؟!»([682]).
أوّلاً: إنّ الاعتقاد بوحدة الوجود هو من اعتقادات الفلاسفة والعرفاء الإسلاميين ولا يختص بالصوفية.
ثانياً: المعتقدون بوحدة الوجود من الفلاسفة والعرفاء يبرهنون على مدعاهم بأدلة عقلية ونقلية، لذا لا يمكن عدّ بطلان هذه العقيدة أمراً من المسلّمات الضرورية.
ويقول الميرزا جواد آقا الملكي التبريزي في تقريره:
«فالّذي يمكن تقريبه إلى الأذهان العامة المستقيمة بدلالات ظاهرة غير عميقة أنّ الحقّ تعالى جلّ جلاله لا إشكال في كون وجوده الخارجي غير محدود بحدّ وغير فاقد لكمال وأنّه موجود في كلّ مكان وزمان وجوداً حقيقياً خارجياً.
وهذه التّصديقات لا أظنّ مخالفاً فيها مسلماً، وأمّا الشيعي فاتّفاقهم على ذلك ممّا لا ريب فيه، وتصوير هذه التصديقات مع ما يتراءى من وجود العالم ـ جواهره وأعراضه ـ لا إشكال في إشكاله على من له أدنى فهم؛ لأنّ معنى تصديق وجود خارجي غير محدود في مرتبة من مراتب الوجود ملازم للتصديق بأنّه لا شريك له في الوجود؛ لأنّ الشّريك في الوجود الخارجي وإن كان محدوداً من جهة أنّه واجد مرتبة من مراتب الوجود الخارجي لا يلائم وجوده بموجود خارجي آخر غير فاقد لمرتبة من مراتب الوجود الخارجي؛ لأنّ المفروض أنّ غير المحدود جزئي حقيقي ووجوده الخارجي غير محدود بحدّ (أي غير فاقد لشيء من مراتب الوجود الخارجي).
فلأجل ذلك فانقسم القائلون بالتّصديقات المذكورة مع ما يرونه من وجود العالم في الخارج إلى طوائف.
قال بعضهم: إنّ العالم وجوده ليس وجوداً حقيقياً بل وجود اعتباري ظلّيّ كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء. وقالوا: وجود الحقّ يساوق بالفارسية (بود) ووجود العالم (نمود) بل كلّما يرى ويتخيّل ويتعقّل من العالم فهو من أسماء الله وصفاته وأفعاله وليس في الوجود إلّا الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبعبارة أخرى: ليس إلّا الحقّ وشؤونه، ومثّلوا لذلك بأمثلة كثيرة.
وقال الآخرون بأنّا إنّما نقول بهذه التصديقات تعبّداً ولكن نرى وجود العالم، بجواهره وأعراضه، وجداناً وعياناً وليس لنا أن نتعقّل تصوير غير محدوديّته تعالى وأنّه كيف هو؟! وأنّه كيف يتصوّر ذلك مع القول بوجود العالم؟! ونحن غير مكلّفين بذلك بل منهيّون عن الفكر والبحث عنه.
وبعضهم لم يتصوّروا من الوجود إلّا الذهني والاعتباري ولم يروا مناقضة بين التصديقات ووجود العالم.
وبعضهم استراحوا رأساً بأنّ معرفة صفات الله غير ممكنة لأحد من المخلوقين ولو كان من الأنبياء^؛ لأنّه تعالى منزّه عن أن يعرف أسماؤه وصفاته ولو إجمالاً.
وأورد الكل على الأوّلين بأنّ قولكم بأنّ وجود العالم ليس وجوداً حقيقياً يستلزم الكفر؛ لأنّه قول بأنّ كلّ شيء هو الله وهذا من جهة أنّه قول بالاتّحاد كفر صريح مخالف للتّوحيد، وأنّ هذه الجبال الرّواسي والحديد الّذي فيه بأس شديد كيف يمكن أن يقال: إنّ وجودهما ليس حقيقياً بل هي مرايا وظلال وخيال بل شؤون، وكيف يمكن أن يقال: إنّ الأعيان النجسة بل النّفوس الخبيثة من أسماء الله وصفاته أو أفعاله وأنّه إن كان كما يقولون فكيف اللذّات والآلام؟!
وأجيب عن ذلك كلّه بأنّ نفي الوجود الحقيقي عن الأشياء ليس قولاً بأنّ كلّ شيء هو الله وليس قولاً بالاتّحاد»([683]).
ويخرج بنتيجة نهائية مما تقدّم:
«وبالجملة، نفي الوجود عن الموجودات ليس قولاً باتّحاد الموجودات مع الله والوحدة غير الاتحاد؛ لأنّ الاتّحاد لا يكون إلّا بين شيئين وهو لا يوافق القول بالوحدة»([684]).
ثالثاً: تمّ الاستشهاد في مقام الاستدلال على وحدة الوجود بهذه العبارة من الدعاء:
«أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المظْهِرَ لَكَ؟!»([685]).
ومن الممكن أن يكون المقصود منها أظهرية وجود الله تعالى على وجود مخلوقاته.
وجاء عن العلامة المجلسي في ذلك:
«قال بعض المنسوبين إلى العلم: اعلم أنّ أظهر الموجودات وأجلاها هو الله} فكان هذا يقتضي أن يكون معرفته أوّل المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول...»([686]).
وقال أيضاً في كتاب (مرآة العقول):
«والحاصل أنّ وجوده تعالى أظهر الأشياء ولا يحتاج في ظهوره إلى بيان أحد، وقد أظهر الدلائل على وجوده وعلمه وقدرته في الآفاق وفي أنفسهم، وهو مظهر الأنبياء والرسل وفضلهم وكمالهم وهو مفيض العلم والجود عليهم، وعلى جميع الخلق، فهو سبحانه المظهر لنفسه ولغيره وجوداً وكمالاً ومعرفة كما قال سيّد الشهداء× في دعاء يوم عرفة: (كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ؟! أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المظْهِرَ لَكَ؟! مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْكَ؟! وَمَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَكُونَ الْآثَارُ هِيَ الَّتِي تُوصِلُ إِلَيْكَ؟! عَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ عَلَيْهَا رَقِيباً) إلى آخر الدعاء»([687]).
وهناك من فهم معنى آخر من كلمات سيّد الشهداء× في الدعاء ومنهم آية الله الميرزا حسنعلي مرواريد، حيث قال:
«ومنه: ما في هذا الدعاء: (كَيْفَ يُسْتَدَلُّ عَلَيْكَ بِمَا هُوَ فِي وُجُودِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَيْكَ؟! أَيَكُونُ لِغَيْرِكَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَيْسَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ هُوَ المظْهِرَ لَكَ؟!) بدعوى أنّ ظهوره هو وجوده، وصريحه أنّ الظهور لك لا لغيرك.
وفيه: إمكان أن يكون المراد أنّ وجود الغير المفتقر إلى الله تعالى ليس له بنفسه ظهور حتّى يكون هو المظهر له تعالى من أجل أنّه آية له، بل ظهور وجود الغير إنّما هو به تعالى، فهو المظهر لوجود الغير الذي هو آية له تعالى، والمظهر لنفسه تعالى أيضاً من أجل أنّه ذو الآية.
ومنه: ما فيه أيضاً: (تَعَرَّفْتَ إِلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَرَأَيْتُكَ ظَاهِراً فِي كُلِّ شَيْءٍ) بدعوى أنّ كونه ظاهراً في كل شيء من جهة أنّه وجود كل شيء.
وفيه: ما مرّ من إمكان كون المراد هنا أيضاً ظهور ذي الآية بالآيات الموجودة بحكم العقل، نظير ما في الحديث: (جَعَلَ الخلْقَ دَلِيلاً عَلَيْهِ فَكَشَفَ بِهِ عَنْ رُبُوبِيَّتِهِ)([688])»([689]).
ط) التعبير بـ(جذبة) في هذا الدعاء
ومن جملة الإشكالات التي أوردت على المحتوى أيضاً عبارة: «وَاسْلُكْ بِي مَسْلَكَ أَهْلِ الجذْبِ»([690])، حيث قيل: إنّ هذه الكلمة (جذبة) من تعبيرات العرفاء.
أوّلاً: من أين نعلم أنّ هذا الاصطلاح لم يستله العرفاء من مثل دعاء عرفة.
ثانياً: جاء في القرآن الكريم ما يشبه هذا التعبير:
حيث يقول تعالى:
(وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ)([691]).
إذ إنّ (الرفع) نوع من الجذب أيضاً.
ثالثاً: وروي عن الإمام علي× أنّه قال:
«مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَنَاصِيَتُهُ بِيَدِ مَلَكٍ فَإِنْ تَكَبَّرَ جَذَبَهُ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَقَالَ لَهُ: تَوَاضَعْ! وَضَعَكَ اللهُ، وَإِنْ تَوَاضَعَ جَذَبَهُ بِنَاصِيَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ! رَفَعَكَ اللهُ، وَلَا وَضَعَكَ بِتَوَاضُعِكَ لِلهِ»([692]).
تدلّ الرواية على وجود نوعين من الجذبة الإلهية: واحدة إيجابية وأخرى سلبية، وتتحقق الأولى برفيع الدرجات في ظروف خاصة.
رابعاً: لقد أشير في بعض الروايات إلى مسائل تخص الأولياء والعرفاء.
وروى الكليني بسنده عن حمّاد بن بشير أنّه قال:
«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ× يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ|: قَالَ اللهُ: مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي عَنْ مَوْتِ المؤْمِنِ، يَكْرَهُ الموْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»([693]).
وروى بسنده أيضاً عن الإمام الباقر× أنّه قال:
«لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ| قَالَ: يَا رَبِّ مَا حَالُ المؤْمِنِ عِنْدَكَ؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ بَارَزَنِي بِالمحَارَبَةِ، وَأَنَا أَسْرَعُ شَيْءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي عَنْ وَفَاةِ المؤْمِنِ، يَكْرَهُ الموْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ المؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى وَلَوْ صَرَفْتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَهَلَكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِيَ المؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ صَرَفْتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَهَلَكَ، وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ إِذاً سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ»([694]).
وروى بسنده أيضاً عن الإمام الصادق× قوله:
«قَالَ رَسُولُ اللهِ|: لَقَدْ أَسْرَى رَبِّي بِي فَأَوْحَى إِلَيَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَوْحَى وَشَافَهَنِي [إِلَى] أَنْ قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَنِي بِالمحَارَبَةِ وَمَنْ حَارَبَنِي حَارَبْتُهُ، قُلْتُ: يَا رَبِّ وَمَنْ وَلِيُّكَ هَذَا؟ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ مَنْ حَارَبَكَ حَارَبْتَهُ، قَالَ لِي: ذَاكَ مَنْ أَخَذْتُ مِيثَاقَهُ لَكَ وَلِوَصِيِّكَ وَلِذُرِّيَّتِكُمَا بِالْوَلَايَةِ»([695]).
وروى بسنده أيضاً عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«قَالَ رَسُولُ اللهِ|: قَالَ اللهُ: مَنِ اسْتَذَلَّ عَبْدِيَ المؤْمِنَ فَقَدْ بَارَزَنِي بِالمحَارَبَةِ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ كَتَرَدُّدِي فِي عَبْدِيَ المؤْمِنِ، إِنِّي أُحِبُّ لِقَاءَهُ فَيَكْرَهُ الموْتَ فَأَصْرِفُهُ عَنْهُ، وَإِنَّهُ لَيَدْعُونِي فِي الْأَمْرِ فَأَسْتَجِيبُ لَهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ»([696]).
وقال الفيض الكاشاني خلال بيانه هذه الأحاديث:
«وأمّا معنى التقرّب إلى الله ومحبة الله للعبد وكون الله سمع المؤمن وبصره ولسانه ويده ففيه غموض لا يناله أفهام الجمهور، وقد أودعناه في كتابنا الموسوم بـ(الكلمات المكنونة)، وإنّما يرزق فهمه من كان من أهله.
قال شيخنا البهائي& في أربعينه: معنى محبة الله سبحانه للعبد هو كشف الحجاب عن قلبه وتمكينه من أن يطأ على بساط قربه فإنّ ما يوصف به سبحانه إنّما يؤخذ باعتبار الغايات لا باعتبار المبادئ، وعلامة حبه سبحانه للعبد توفيقه للتجافي عن دار الغرور والترقي إلى عالم النور والأنس بالله والوحشة مما سواه وصيرورة جميع الهموم هماً واحداً.
قال بعض العارفين: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك.
قال&: ولأصحاب القلوب في هذا المقام كلمات سنية وإشارات سرية وتلويحات ذوقية تعطر مشام الأرواح وتحيي رميم الأشباح لا يهتدي إلى معناها ولا يطلع على مغزاها إلّا من أتعب بدنه في الرياضات وعنى نفسه بالمجاهدات حتّى ذاق مشربهم وعرف مطلبهم.
وأمّا من لم يفهم تلك الرموز ولم يهتد إلى هاتيك بالكنوز لعكوفه على الحظوظ الدنية وانهماكه في اللذات البدنية فهو عند سماع تلك الكلمات على خطر عظيم من التردي في غياهب الإلحاد والوقوع في مهاوي الحلول والاتحاد تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. قال: ونحن نتكلم في هذا المقام بما يسهل تناوله على الأفهام فنقول: هذا مبالغة في القرب وبيان لاستيلاء سلطان المحبة على ظاهر العبد وباطنه وسره وعلانيته، فالمراد والله أعلم أنّي إذا أحببت عبدي جذبته إلى محل الأنس وصرفته إلى عالم القدس وصيرت فكره مستغرقاً في أسرار الملكوت وحواسه مقصورة على اجتلاء أنوار الجبروت فيثبت حينئذ في مقام القرب قدمه ويمتزج بالمحبة لحمه ودمه إلى أن يغيب عن نفسه ويذهل عن حسه فيتلاشى الأغيار في نظره حتّى أكون له بمنزلة سمعه وبصره كما قال من قال:
|
جنوني فيك لا يخفى |
انتهى كلامه. ولعل المراد بالمأخوذ ميثاقه في الحديث الأخير الذي أقر به وثبت على إقراره حتّى وفى به؛ وذلك لأنّ منهم من كذب وأنكر، ومنهم من أقر ولم يثبت عليه ولم يف به»([697]).
ي) لا تتناسب بعض فقرات هذه الزيادة مع مقام الإمام
ومن الإشكالات التي أوردت على مضمون الزيادة تضمّنها لبعض الفقرات التي لا تتناسب ومقام الإمام×، ومنها ما نقل عن الإمام الحسين× في تلك الزيادة حيث قال:
«إِلَهِي أَخْرِجْنِي مِنْ ذُلِّ نَفْسِي، وَطَهِّرْنِي مِنْ شَكِّي وَشِرْكِي»([698]).
يشتمل هذا المعنى على حيثيتي الدفع والرفع وما يصدق بخصوص الإمام المعصوم هي الحيثية الأولى لا الثانية، بمعنى أنّ الإمام× يطلب من الله أن يصونه عن الشكوك والشبهات والوقوع بالشرك، كما ورد مثل هكذا تعبيرات في آيات القرآن الكريم وفي روايات وأدعية أهل البيت^ أو ما يتعلّق بهم.
أ) الآيات:
قال الله تعالى:
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([699]).
بينما يقول في آية أخرى:
(فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ) ([700]).
حيث يجب حمل كلمة (الرجس) الواردة فيها على الدفع لا الرفع.
ب) الروايات والأدعية:
روي عن الإمام السجاد× أنّه في دعاء السابع والأربعين من الصحيفة السجادية (دعاء عرفة)، يدعو الله سبحانه بقوله:
«وَأَزِلْ عَنِّي كُلَّ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ»([701]).
و في دعاء أبي حمزة، جاء حمده وثناؤه بهذه العبارة:
«فَلَكَ الحمْدُ عَلَى مَا نَقَّيْتَ مِنَ الشِّرْكِ قَلْبِي»([702]).
وروي عن الإمام الباقر× أنّه خاطب الحق سبحانه في دعاء من أدعيته قائلاً: «وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ»([703]).
ك) لم تنقل الزيادة مع دعاء عرفة في (مصباح الزائر)
الإشكال الذي يرد على نقل الكفعمي هو أنّه نقل دعاء عرفة عن كتاب (مصباح الزائر) للسيّد ابن طاووس؛ إذ لا نعلم عن أيّ نسخة منه نقل الكفعمي دعاء عرفة دون الزيادة في كتابه المصباح، بيد أنّ جميع نسخه ـ مصباح الزائر ـ المخطوطة والمطبوعة خالية من دعاء عرفة وهذه الزيادة.
أوّلاً: احتمل بعض أنّ للسيد ابن طاووس مؤلفين يحملان عنوان (مصباح الزائر)، وهذا الدعاء جاء في (مصباح الزائر الكبير)، وما هو بين أيدينا (مصباح الزائر الصغير).
لقدتناولإيتان كولبرغ مسألة النقل عن مؤلفات ابن طاووس فيما ألف بعده من الكتب:
«إنّ أكثر مؤلف انتفع بمؤلفات ابن طاووس في القرن التاسع هو تلميذ البياضي، أعني تقي الدين إبراهيم بن علي بن حسن العاملي الكفعمي (كان حياً في 895؛ اُنظر: ترجمته في الرياض 1/ 21 ـ 25). (اُنظر: الكفعمي أيضاً في: الباب الثالث الفصل الثامن) إذ كان عنده على أقل تقدير سبعة من مؤلفات ابن طاووس: فتح الأبواب (نقل عن مث: في: الجنّة صص 392 ـ 393 الجنّة صفحة 107 ـ پ)، الدروع (نقل عن مث: في: الجنّة ص 206 الجنّة صفحة 56 ـ ر)، الإقبال، المضمار (وعنوانه الثانوي (كتاب عمل شرح رمضان))، المهج، المجتنى والزائر»([704]).
وكتب في موضع آخر حول مؤلفات الكفعمي وابن طاووس في كتابه قائلاً:
«إنّ أكثر مؤلف إرجاعاً في تأليفاته لابن طاووس في الفاصلة بين وفاة ابن طاووس وتولي الصفوية للحكم هو الكفعمي، فهو كان يستفيد بصورة واسعة من تأليفات ابن طاووس، بل هو كابن طاووس لديه شوق وعلاقة شديدة بكتب الأدعية. حيث يشكل الدعاء الموضوع الرئيس في كتابيه المشهورين: (جنّة الأمان الواقية) (والمعروف أيضاً بـ(المصباح)) الذي انتهى من تدوينه في 895، و(البلد الأمين) والذي كان تأليفه في 868. وكتب الكفعمي على كليهما (تعليقة) تشتمل على شرح المتن (والذي أشير إليه بـ(الأصل)) وبعض المعلومات الإضافية. الطبعة الحجرية لـ(الجنّة) (النجف وطهران 1349 في 774 صفحة) وثلاث نسخ منه توجد في مكتبة جامعة برنستون (ترقيم جديد 454 أرقام الرفوف 536، 985 [جنّة] و 1516) مشتملة الأصل والتعليقات. الطبعة الحجرية لـ(البلد) (طهران 1383 في 613 صفحة) اشتملت على بعض التعليقات المنتخبة فقط. وما يدعو للدهشة بخصوص هذا الكتاب أنّ أكثر مصادره التي تمّ اعتمادها فيه هي كتب ابن طاووس. وليس لدينا اطلاع بخصوص ما إذا كانت بين يدي المؤلفين المتأخرين.
طبعاً هنا يطرح هذا السؤال هل كانت هذه المصادر في متناول يد الكفعمي؟ والمشكلة القائمة في منهجه أنّه لم يجعل فارقاً في النقل عن المصادر بين ما كان بواسطة وما لم يكن بواسطة؛ إذ يبدو للوهلة الأولى أنّ المصادر التي يعتمدها متوفرة لديه. ويؤيّد هذا ما قام به آقا بزرگ حيث يأتي غالباً بالمصدر الذي ينقل عنه ابن طاووس ويشير إليه الكفعمي أيضاً.
ولكن الدراسة الدقيقة لكتابي جنّة الأمان والبلد الأمين تكشف أنّ الكثير ممّا نقل فيهما موجود بعينه في مؤلفات ابن طاووس، وفي الأغلب يؤتى قبل تلك المنقولات وبعدها بعبارات من مؤلفات ابن طاووس ذكر فيها تلك المصادر، والأكثر من (المهج والمجتنى)؛ رغم أنّ ذلك لا يثبت بصورة قطعية أنّ الكفعمي لم يلاحظ أصل تلك المؤلفات، وإنّما يكشف عن كونه قد نقل عن بعضها بواسطة ابن طاووس. وفي مقابل هذه الحالات هناك حالات يصرح فيها الكفعمي أنّه قد شاهد فيها متناً خاصاً. وبغض النظر عن هذه الحالات، لا يمكن الخروج بقاعدة واضحة تحدد أيّ مصدر كان الكفعمي قد لاحظه بنفسه»([705]).
وفي تعريفه لكتاب (مصباح الزائر) قال:
«... يقول ابن طاووس في (اللهوف): كتاب الزائر مصباح لأداء الزيارات بطريقة صحيحة، ويضيف: أنّ لديه نظير هذا الهدف من تأليفه اللهوف. ويقول ابن طاووس في (الإقبال) (489/ 274): إنّ الزائر قد لوحظ فيه اصطحابه للزيارة.
والشاهد على التاريخ المحتمل لتأليف هذا الكتاب جاء في الصفحة 394 من كتاب الزائر. فهو هناك تكلم عن (إجازة) (كانت على إحدى نسخ (كامل الزيارات لابن قولويه)) قائلاً: إنّه حتّى سنة 618 يكون قد مضى عليه 252 سنة هلالية... وفي الذريعة 21، وصف الزائر بأنّه أوّل مؤلفات ابن طاووس. وأساس هذا الرأي عبارة لابن طاووس في (الكشف) بأنّه عندما شرع بالكتابة ألّف (الزائر) (في بداية ما شرعت في التأليف؛ في الإجازات: في بداية التكليف) وهذا سبب خلوه من الأسرار الإلهية (من المحتمل أنّه إشارة إلى تأويل المعاني الباطنية للأدعية المختلفة). وبأيّ نحو كان فإنّ آقا بزرگ يحدس في الذريعة ج 23 بأنّه كان لديه مؤلف قبل منهاج الزائر يرتبط كذلك بقراءة الزيارة عند قبور الأئمة^. واستدل على ذلك من عبارة في بداية كتاب الزائر (في النسخة التي لم أشاهدها) ولكن ما يؤسف له أنّ آقا بزرگ لم يستنطق تلك العبارة، واكتفى بالقول: (وفي أوّل (مصباح الزائر) ما يظهر منه أنّه ألف مزاراً قبله). الشواهد المتوفرة بين أيدينا تدلّ على أنّ مصباح الزائر ومنهاج الزائر عنوانان لكتاب واحد، ولهذا أشير في الإجازات ج 1 إلى منهاج الزائر وفي ج 2 جاء مصباح الزائر (وأيضاً لوحظت إشارات أخرى إلى هذا المؤلف في قسم من كتابات ابن طاووس) وفي الأصل فإنّ المصباح متكوّن من ثلاثة مجلدات ويشتمل على الزيارات التي يجب قراءتها في جوار قبور الأئمة (اُنظر: الإجازات؛ جمال الأسبوع 232؛ العاملي، أمل 2/ 205). وفي المقابل فإنّ (الزائر) (الذي يشتمل على زيارات تقرأ في جوار قبور النبي والأئمة وأهل البيت الآخرين) يتكوّن من عشرين فصلاً ولم يأت حوله اسماً للمجلدات. وهذا قد يكون كاشفاً عن اختلاف في ترتيب متنه، ويبقى احتمال وجود نسخة خطية للزائر محررة عن أصل الكتاب (ولعلها تلخيص له). إنّ وجود هكذا تحرير عن الكتاب أمر قد أشار إليه (حسين علي محفوظ) في (أدب الدعاء) دون ذكر شاهد عليه (البلاغ 1/ 6، 1386، صص 56 ـ 86 ص 63)، حيث إنّه هناك قد فرّق بين مصباح الزائر الصغير (الزائر) ومصباح الزائر الكبير ومنهاج الزائر وجناح المسافر ذو المجلدات الثلاثة (ويحتمل جدّاً أن يكون هو نفس مصباح الزائر الكبير). ويمكن أن تقدّم لنا مقابلة هذه النسخة مع النسخ الأخرى، ونسخة مصباح الزائر طبعة آل البيت في بيروت، صورة أوضح. إنّ الشواهد التي بين أيدينا حتّى الآن ليست قادرة على إبراز نتيجة قطعية، ومن جهة أخرى هناك قرائن تدلّ على أنّ الزائر يشتمل على جميع الزائر، فجميع ما نقله ابن طاووس عن الزائر في مؤلفاته الأخرى موجود في الزائر، ووضح في مقدّمته التي جاءت في الزائر (13) لماذا قام بكتابة كتاب مطوّل في الأدعية، ووعد أن يكتب عند الإمكان ملخصاً لهذا الكتاب. ومن جهة أخرى لم يتضمّن الزائر على الجملة التي أشار إليها آقا بزرگ. وهكذا جاءت المنقولات من كتاب الزيارات والفضائل لابن داود القمي في كشكول البحراني (وإن لم يكن متيقناً أنّ هذه المواد أخذت من الزائر)»([706]).
ثانياً: لو افترضنا عدم وجود الزيادة في (مصباح الزائر)، فيحتمل أنّ الكفعمي نقلها من كتاب آخر لابن طاووس مثل (الإقبال) ونسبها سهواً لكتاب (مصباح الزائر)، ولكن مع ذلك كان نقله عن مصدر معتبر.
وتأييداً لهذا المدّعى، ننقل ما جاء في تتمة لتعليقة في هامش نسخة رقم 10583 في مكتبة العتبة الرضوية المقدّسة المدوّنة بتاريخ 1076 للهجرة([707])، منسوبة للملّا محسن الفيض الكاشاني أو محسن بن محمّد الأسترآبادي (احتمال راجح) حيث قال:
«ثمّ العجب كل العجب من الكفعمي أنّه أسند هذه الرواية بالسيّد في كتابه (مصباح الزائر) كما علمت وليس فيه عين ولا أثر من هذا الدعاء فضلاً عن هذا الخبر فارجع وتبصر، ثمّ لم أجد إلى الآن هذه الرواية التي رواها الأسديان في غير كلام الكفعمي فلعلّه وجدها في غير (المصباح) وأسندها بالكتاب المذكور سهواً، والله تعالى يعلم»([708]).
ل) عدم مجيء الصلوات في الزيادة
مما أشكل به على الزيادة أنّها خلت من الصلوات على محمّد وآل محمّد|، بيد أنّها قد تكررت في نفس الدعاء.
قال حسين ترابي في ذلك:
«في هذه التتمة وذيل الدعاء، لم يأت ذكر الصلوات على محمّد وآله ولو لمرّة واحدة. بينما كان أسلوب الأئمة^ ودأبهم قائماً على أنّهم وخصوصاً في الأدعية المفصلة والطويلة، حتّى لو لم يصلّوا على النبي وآله في بداية الدعاء فإنّه سيأتي ذكر الصلوات في أواسط الدعاء أو خاتمته ويتكرر فيه اسم محمّد وآل محمّد.
وهذا دعاء عرفة لسيّد الشهداء أيضاً هكذا إذ يصلى على محمّد وآل محمّد بعد صفحتين ونصف منه بمناسبة ذكر الأنبياء والرسل، أي بعد سبعة أسطر خاتمة الفقرة الأولى من الدعاء. عندها تبدأ الفقرة الثانية من الدعاء وبعد مضي 12 سطراً تقريباً تأتي الصلوات، وبعد 15 سطراً أخرى أيضاً يصلى على النبي وآله، ثمّ بعد ما يقارب الثلاث صفحات ونصف تأتي الصلوات على محمّد وآله. وما تنقضي خمسة أسطر حتّى تأتي صلوات أخرى، وبعد سبعة أسطر أيضاً يتكرر ذكر الصلوات، وهكذا بعد أربعة أسطر، وبعد سطرين يصلى محمّد وآله، حتّى آخر الدعاء، أي الفقرة الثالثة وقد بقي ثلاثة أسطر من نهاية الدعاء تأتي الصلوات على محمّد وآله.
أمّا في التتمة، لم يأت اسم النبي وآله، وهذا تفاوت ملحوظ بينها والأدعية المأثورة»([709]).
ليس من اللازم مجيء الصلوات في جميع فقرات الدعاء ومقاطعه، كما أنّك ذكرت أنّ ذكر الصلوات قد جاء مرات ومرات في الفقرات الأولى من دعاء عرفة الشريف، فما الضير إن لم يأت ذكرها في القسم الأخير المختص تقريباً بمعرفة الله تعالى، وهل يعدّ ذلك دليلاً على عدم صحة هذا القسم من الدعاء وعدم مضاهاته للأدعية الأخرى؟!
فهذا دعاء كميل الذي لا يشك فيه أحد، طالعه وستجد أنّه جاء ذكر الصلوات فقط في السطر الأخير منه مع أنّه يتألف من عدّة صفحات. فما المشكلة إن لم يأت ذكر الصلوات في صفحة واحدة من عدّة صفحات يتكوّن منها الدعاء، أو مثل ذلك دليل عدم صحته؟!
وهناك أدعية كثيرة لم يأت فيها ذكر الصلوات إلّا في آخرها أو في مطاويها لمرّة أو لمرّتين، فهل هناك شرط في الدعاء يا ترى بأن يملأ بالصلوات؟!
أو يقلل عدم مجيء ذكر الصلوات في الكثير من المناجاة من قيمتها واعتبارها؟! اقرأ مناجاة (مولاي يا مولاي)، وقلّب أسطر المناجاة الخمسة عشر.
وهذا الشيخ الطوسي اسمع ما يقوله في (مصباح المتهجد):
«... ثُمَّ تَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: الحمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ، الحمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ. ثُمَّ يَدْعُو بِدُعَاءِ الحزِينِ. أُنَاجِيكَ يَا مَوْجُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، لَعَلَّكَ تَسْمَعُ نِدَايَ فَقَدْ عَظُمَ جُرْمِي وَقَلَّ حِيلَتِي. مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ! أَيَّ الْأَهْوَالِ أَتَذَكَّرُ وَأَيَّهَا أَنْسَى! وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا الموْتُ لَكَفَى! كَيْفَ وَمَا بَعْدَ الموْتِ أَعْظَمُ وَأَدْهَى يَا مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ! حَتَّى مَتَى وَإِلَى مَتَى أَقُولُ لَكَ الْعُتْبَى مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ثُمَّ لَا تَجِدُ عِنْدِي صِدْقاً وَلَا وَفَاءً، فَيَا غَوْثَاهُ ثُمَّ وَا غَوْثَاهُ بِكَ يَا اللهُ! مِنْ هَوىً قَدْ غَلَبَنِي وَمِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَكْلَبَ عَلَيَّ، وَمِنْ دُنْيَا قَدْ تَزَيَّنَتْ لِي، وَمِنْ نَفْسٍ أَمَّارَةٍ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي، مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ! إِنْ كُنْتَ رَحِمْتَ مِثْلِي فَارْحَمْنِي وَإِنْ كُنْتَ قَبِلْتَ مِثْلِي فَاقْبَلْنِي يَا قَابِلَ السَّحَرَةِ اقْبَلْنِي! يَا مَنْ لَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّفُ مِنْهُ الحسْنَى! يَا مَنْ يُغَدِّينِي بِالنِّعَمِ صَبَاحاً وَمَسَاءً ارْحَمْنِي يَوْمَ آتِيكَ فَرْداً شَاخِصاً إِلَيْكَ بَصَرِي، مُقَلَّداً عَمَلِي قَدْ تَبَرَّأَ جَمِيعُ الخلْقِ مِنِّي نَعَمْ وَأَبِي وَأُمِّي وَمَنْ كَانَ لَهُ كَدِّي وَسَعْيِي، فَإِنْ لَمْ تَرْحَمْنِي فَمَنْ يَرْحَمُنِي وَمَنْ يُونِسُ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي وَمَنْ يُنْطِقُ لِسَانِي إِذَا خَلَوْتُ بِعَمَلِي وَسَاءَلَتْنِي عَمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ فَأَيْنَ المهْرَبُ مِنْ عَدْلِكَ، وَإِنْ قُلْتُ: لَمْ أَفْعَلْ، قُلْت: أَلَمْ أَكُنِ الشَّاهِدَ عَلَيْكَ، فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ يَا مَوْلَايَ قَبْلَ سَرَابِيلِ الْقَطِرَانِ، عَفْوَكَ عَفْوَكَ يَا مَوْلَايَ قَبْلَ أَنْ تُغَلَّ الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرَ الْغَافِرِينَ»([710]).
فلم يأت ذكر الصلوات على أهل البيت^ في هذا الدعاء.
م) لم يأت ذكر موقف الحج وعرفات في الزيادة
من الإشكالات التي أوردت على هذه الزيادة أنّها لم يرد فيها ذكر لموقف الحج وعرفات بأيّ نحو من الأنحاء، بيد أنّ سيّد الشهداء× قد أتى على ذكرها في نفس دعاء عرفة مرات عديدة.
فقال حسين ترابي:
«لم يرد ذكر موقف الحج وعرفة في أيّ موضع من الدعاء، بينما قد ذكرها الإمام× في نفس الدعاء مرات عديدة في بعض المناسبات»([711]).
هل من الضروري والمحتم أن يأتي اسم مسجد الكوفة مثلاً في دعاء المسجد أو مناجاته، أو يجب أن يذكر بنحو وأسلوب بحيث يؤدي عدم ذكره كذلك إلى سريان الشك والترديد في حجية واعتبار ذلك الدعاء أو تلك المناجاة؟!
ن) احتمال إنشاء الزيادة من قبل السيّد ابن طاووس
كما ذكرنا فيما سبق أنّ هذا الاحتمال نقل عن آية الله بهجت.
وقد نقل ذلك محمّد صادق الكرباسي بقوله:
«إنّ ابن طاوُس قد صاغ الكثير من الأدعية والزيارات كما يشاهد ذلك في كتابه (مهج الدعوات) وغيرهما مما يقرب احتمال أنّ الزيادة من تأليفه أو لا نستبعدها على أقل تقدير»([712]).
وقال هو في مقام الرد على هذا الإشكال:
«وهذا لا ينتقص من قدر الدعاء ولا يسقطه من الاعتبار؛ لأنّه+ كان عارفاً بموارد الدعاء والزيارة ويستسقي نصوصها من الآيات والروايات، وفي هذا المجال يقول الطهراني في كتابه (الذريعة 2 / 265) لدى حديثه عن كتاب (الإقبال): (وليس فيها من منشآت السيّد إلّا في عدّة مواضع صرّح فيها بأنّه لم يجد في كتب الأدعية دعاءً خاصاً به فأنشأ دعاءً من نفسه)»([713]).
صارت قصة أرينب موضع اهتمام كثير من الباحثين ومحلاً لاختلاف وجهات النظر؛ لما لها ارتباط بسيّد الشهداء× وما دار من حديث بينه× وبين بعض شخوص القصة، فذهب بعض إلى منافاتها لمقام العصمة وآخرون إلى أنّها على العكس تماماً إذ إنّها تمثل شاهداً رائعاً على عظمة ومقام الإمام الحسين×.
ويقول آية الله الصافي الگلپايگاني:
«من القصص التي تظهر مدى اهتمام الإمام الحسين× بالدفاع عن المظلومين وحماية المساكين قصة أرينب بنت إسحاق وزوجة عبد الله بن سلام.
تزيح هذه القصة المعروفة الستار عن انحطاط بني أمية وسقوطهم الأخلاقي، ومدى حقارة ورذالة معاوية ويزيد، وتظهر منتهى الدناءة والضعة وعدم الإنسانية عند غاصبي خلافة المسلمين والمتسلّطين على حكمهم.
نقل هذه القصة ابن قتيبة، والشبراوي، والعلايلي، والنويري، وابن بدرون وآخرون، كما تمّ تأليف كتاب مستقل حولها، وبما أنّها قصة مشهورة وطويلة، نُرجع القرّاء إلى مطالعة مصادرها العربية، ونشير هنا إليها بشكل مختصر:
إنّ يزيد الذي سمّي بالأمير وولي العهد لمعاوية والذي سُخّرت له الكثير من أسباب الفسق والفجور من مال ومنصب وجوار حسان وراقصات ومغنيات لكن كل ذلك لم يشبع نهمه حتّى تطاول طامعاً بامرأة متزوجة كان من المفترض أن يدافع هو وأبوه عن عفتها وكرامتها، لكن صدر منه العكس، فحاك لنيلها أشدّ أساليب أهل الرذائل والشهوات ممن يتربون في وفور العيش المرفّه في البلاط الجائر، وبما أنّها كانت من النساء العفيفات ولم يكن من السهل بلوغ غايته مهما توسل بالسبل المنحرفة والخدّاعة، تدخل معاوية الذي يدعي إمرة المؤمنين وقام بمكرٍ عجيبٍ لم يسبقه مثيل فأوقع الخلاف والفرقة بين تلك المرأة العفيفة وزوجها كي يهيّئ المقدّمات اللازمة لنيل ابنه يزيد غايته من تلك المرأة.
ولكن الحسين× بغيرته وفتوته وشهامته أفشل تلك الخطة الشيطانية لمعاوية، وأظهر الغيرة والحمية الهاشمية وعلاقته بحفظ نواميس المسلمين وشرفهم، ومنع يزيد من تحقيق شهواته ورغباته الشريرة، وآلت الفرقة التي أوجدها معاوية بالمكر والخداع وما يمتلكه من إمكانيات وحوّلها× إلى ارتباط من جديد ودفع عن عبد الله بن سلام وزوجته ذلك الظلم الكبير، وخلّد هذه القصة في التاريخ كواحدة من مفاخر آل علي× ومظالم بني أمية»([714]).
وبما أنّ هذه الموسوعة مهتمة بكلام سيّد الشهداء× ومنها كلامه في هذه القصة، واستخرجت بعض النكات والموضوعات الهامة، مضافاً إلى أنّ أصل القصة كانت محل جدل ونقاش في السند والدلالة من قبل عدّة، لهذا وجدنا من المناسب بحثها في مدخل هذه الموسوعة والإجابة عما أثير حولها من الشبهات.
نقل ابن قتيبة:
«قال: وذكروا أنّ يزيد بن معاوية سهر ليلة من الليالي، وعنده وصيف لمعاوية يقال له رفيق، فقال يزيد: أستديم الله بقاء أمير المؤمنين وعافيته إياه، وأرغب إليه في تولية أمره وكفاية همه، فقد كنت أعرف من جميل رأي أمير المؤمنين في، وحسن نظره في جميع الأشياء ما يؤكد الثقة في ذلك والتوكل عليه، منعني من البوح بما جمجمت في صدري له، وتطلابه إليه، فأضاع من أمري وترك من النظر في شأني، وقد كان في حلمه، وعلمه، ورضائه، ومعرفته، بما يحق لمثله النظر فيه، غير غافل عنه، ولا تارك له، مع ما يعلم من هيبتي له وخشيتي منه، فالله يجزيه عنّي بإحسانه، ويغفر له ما اجترح من عهده ونسيانه، فقال الوصيف: وما ذلك جعلت فداك؟ لا تلم على تضييعه إياك، فإنّك تعرف تفضيله لك، وحرصه عليك، وما يخامره من حبك، وأن ليس شيء أحب إليه، ولا آثر عنده منك لديه، فاذكر بلاءه، واشكر حباءه فإنّك لا تبلغ من شكره إلّا بعون من الله.
قال: فأطرق يزيد إطراقاً عرف الوصيف منه ندامته على ما بدا منه، وباح به، فلما آب من عنده توجه نحو سدة معاوية ليلاً وكان غير محجوب عنه، ولا محبوس دونه، فعلم معاوية أنّه ما جاء به إلّا خبر أراد إعلامه به. فقال له معاوية: ما وراءك؟ وما جاء بك؟ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين، كنت عند يزيد ابنك، فقال فيما استجرّ من الكلام كذا وكذا، فوثب معاوية وقال: ويحك ما أضعنا منه؟ رحمة له، وكراهية لما شجاه وخالف هواه؟ وكان معاوية لا يعدل بما يرضيه شيئاً. فقال: عليّ به، وكان معاوية إذا أتت الأمور المشكلة المعضلة، بعث إلى يزيد يستعين به على استيضاح شبهاتها واستسهال معضلاتها، فلما جاءه الرسول قال: أجب أمير المؤمنين، فحسب يزيد إنمّا دعاه إلى تلك الأمور التي يفزع إليه منها، ويستعين برأيه عليها، فأقبل حتّى دخل عليه، فسلّم ثمّ جلس، فقال معاوية: يا يزيد ما الّذي أضعنا من أمرك، وتركنا من الحيطة عليك، وحسن النظر لك، حيث قلت ما قلت؟ وقد تعرف رحمتي بك، ونظري في الأشياء التي تصلحك، قبل أن تخطر على وهمك، فكنت أظنك على تلك النعماء شاكراً، فأصبحت بها كافراً، إذ فرط من قولك ما ألزمتني فيه إضاعتي إياك، وأوجبت عليّ منه التقصير، لم يزجرك عن ذلك تخوف سخطي، ولم يحجزك دون ذكره سالف نعمتي، ولم يردعك عنه حق أبوتي، فأيّ ولد أعق منك وأكيد، وقد علمت أنّي تخطأت الناس كلهم في تقديمك، ونزلتهم لتوليتي إياك، ونصبتك إماماً على أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وفيهم من عرفت، وحاولت منهم ما علمت؟ قال: فتكلّم يزيد، وقد خنقه من شدّة الحياء الشرق وأخضله من أليم الوجد العرق. قال: لا تلزمني كفر نعمتك، ولا تنزل بي عقابك، وقد عرفت نعمة مواصلتك ببرك، وخطوي إلى كل ما يسرك، في سري وجهري فليسكن سخطك، فإنّ الّذي أرثي له من أعباء حمله وثقله، أكثر مما أرثي لنفسي، من أليم ما بها وشدّته، وسوف أنبئك وأعلمك أمري.
كنت قد عرفت من أمير المؤمنين استكمل الله بقاءه، نظراً في خيار الأمور لي، وحرصاً على سياقها إليّ، وأفضل ما عسيت أستعد له بعد إسلامي المرأة الصالحة، وقد كان ما تحدث به من فضل جمال أرينب بنت إسحاق وكمال أدبها ما قد سطع وشاع في الناس، فوقع منّي بموقع الهوى فيها، والرغبة في نكاحها، فرجوت ألا تدع حسن النظر لي في أمرها، فتركت ذلك حتّى استنكحها بعلها، فلم يزل ما وقع في خلدي ينمو ويعظم في صدري، حتّى عيل صبري، فبحت بسري، فكان مما ذكرت تقصيرك في أمري، فالله يجزيك أفضل من سؤالي وذكري. فقال له معاوية: مهلاً يا يزيد، فقال: علام تأمرني بالمهل وقد انقطع منها الأمل؟ فقال له معاوية: فأين حجاك ومروءتك وتقاك؟ فقال يزيد: قد يغلب الهوى على الصبر والحجا، ولو كان أحد ينتفع فيما يبتلي به من الهوى يتقاه، أو يدفع ما أقصده بحجاه، لكان أولى الناس بالصبر داود×، وقد خبرك القرآن بأمره. فقال معاوية: فما منعك قبل الفوت من ذكره؟ قال: ما كنت أعرفه، وأثق به من جميل نظرك، قال: صدقت، ولكن اكتم يا بني أمرك بحلمك، واستعن بالله على غلبة هواك بصبرك، فإنّ البوح به غير نافعك، والله بالغ أمره، ولا بدّ مما هو كائن.
وكانت أرينب بنت إسحاق مثلاً في أهل زمانها في جمالها، وتمام كمالها وشرفها، وكثرة مالها، فتزوجها رجل من بني عمها يقال له عبد الله بن سلام من قريش، وكان من معاوية بالمنزلة الرفيعة في الفضل. ووقع أمر يزيد من معاوية موقعاً ملأه همّاً، وأوسعه غماً، فأخذ في الحيلة والنظر أن يصل إليها، وكيف يجمع بينه وبينها حتّى يبلغ رضا يزيد فيها. فكتب معاوية إلى عبد الله بن سلام:
وكان قد استعمله على العراق، أن أقبل حين تنظر في كتابي هذا الأمر حظك فيه كامل، ولا تتأخر عنه، فأعد المصير والإقبال. وكان عند معاوية بالشام أبو هريرة وأبو الدرداء، صاحبا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما قدم عبد الله بن سلام الشام، أمر معاوية أن ينزل منزلاً قد هيئ له، وأعد له فيه نزله، ثمّ قال لأبي هريرة وصاحبه: إنّ الله قسم بين عباده قسماً، ووهبهم نعماً أوجب عليهم شكرها، وحتّم عليهم حفظها، وأمرهم برعاية حقها، وسلطان طريقها، بجميل النظر، وحسن التفقد لمن طوقهم الله أمره، كما فوضه إليهم، حتّى يؤدوا إلى الله الحق فيهم كما أوجبه عليهم، فحياني منها بأعز الشرف، وسمو السلف، وأفضل الذكر، وأغدق اليسر، وأوسع علي في رزقه، وجعلني راعي خلقه، وأمينه في بلاده، والحاكم في أمر عباده، ليبلوني أأشكر آلاءه أم أكفرها، فإياه أسأله أداء شكره، وبلوغ ما أرجو بلوغه، من عظيم أجره، وأوّل ما ينبغي للمرء أن يتفقده وينظر فيه، فيمن استرعاه الله أمره من أهله ومن لا غنى به عنه.
وقد بلغت لي ابنة أردت إنكاحها، والنظر فيمن يريد أن يباعلها. لعل من
يكون بعدي يهتدي منه بهديي، ويتبع فيه أثري، فإنّي قد تخوفت أن يدعو من يلي هذا
الأمر من بعدي زهوة السلطان وسرفه إلى عضل نسائهم، ولا يرون لهنّ فيمن ملكوا أمره
كفؤاً ولا نظيراً، وقد رضيت لها عبد الله بن سلام لدينه وفضله ومروءته وأدبه. فقال
أبو هريرة وأبو الدرداء: إنّ أولى الناس برعاية أنعم الله وشكرها، وطلب مرضاته
فيها فيما خصه به منها، أنت صاحب رسول الله وكاتبه. فقال معاوية: اذكروا له ذلك عنّي،
وقد كنت جعلت لها في نفسها شورى، غير أنّي أرجو أنهّا لا تخرج من رأيي إن شاء
الله، فلما خرجا من عنده متوجهين إلى منزل عبد الله بن سلام بالذي قال لهما، قال:
ودخل معاوية إلى ابنته، فقال لها: إذا دخل عليك أبو هريرة وأبو الدرداء، فعرضا
عليك أمر عبد الله بن سلام، وإنكاحي إياك منه، ودعواك إلى مباعلته، وحضاك على
ملاءمة رأيي، والمسارعة إلى هواي. فقولي لهما: عبد الله بن سلام كفؤ كريم، وقريب
حميم، غير أنّه تحته أرينب بنت إسحاق، وأنا خائفة أن يعرض لي من الغيرة ما يعرض
للنساء، فأتولى منه ما أسخط الله فيه، فيعذّبني عليه، فأفارق الرجاء، وأستشعر
الأذى، ولست بفاعلة حتّى يفارقها، فذكر ذلك أبو هريرة وأبو الدرداء لعبد الله بن
سلام، وأعلماه بالذي أمرهما معاوية، فلما أخبراه سرّ به وفرح، وحمد الله عليه، ثمّ
قال: نستمتع الله بأمير المؤمنين، لقد والى عليّ من نعمه، وأسدى إلي من مننه،
فأطول ما أقوله فيه قصير، وأعظم الوصف لها يسير. ثمّ أراد إخلاطي بنفسه، وإلحاقي
بأهله، إتماماّ لنعمته، وإكمالاّ لإحسانه، فالله أستعين على شكره، وبه أعوذ من
كيده ومكره. ثمّ بعثهما إليه خاطبين عليه، فلما قدما، قال لهما معاوية: قد تعلمان
رضائي به وتنخلي إياه، وحرصي عليه، وقد كنت أعلنتكما بالذي جعلت لها في نفسها من
الشورى، فادخلا إليها، واعرضا عليها الّذي رأيت لها، فدخلا عليها وأعلماها بالذي
ارتضاه لها أبوها، لما رجا من ثواب الله عليه. فقالت لهما كالذي قال لها أبوها،
فأعلماه بذلك، فلما ظن أنّه لا يمنعها منه إلّا أمرها، فارق زوجته، وأشهدهما على
طلاقها، وبعثهما خاطبين إليه أيضاً، فخطبا، وأعلما معاوية بالذي كان من فراق عبد
الله بن سلام امرأته، طلابا لما يرضيها، وخروجاً عما يشجيها، فأظهر معاوية كراهية
لفعله، وقال: ما أستحسن له طلاق امرأته، ولا أحببته، ولو صبر ولم يعجل لكان أمره
إلى مصيره، فإنّ كون ما هو كائن
لا بدّ منه، ولا محيص عنه، ولا خيرة فيه للعباد، والأقدار غالبة، وما سبق في علم
الله
لا بدّ جار فيه، فانصرفا في عافية، ثمّ تعودان إلينا فيه، وتأخذان إن شاء الله
رضانا. ثمّ كتب إلى يزيد ابنه يعلمه بما كان من طلاق أرينب بنت إسحاق عبد الله بن
سلام، فلما عاد أبو هريرة وأبو الدرداء إلى معاوية أمرهما بالدخول عليها، وسؤالها
عن رضاها تبريا من الأمر، ونظرا في القول والعذر، فيقول: لم يكن لي أن أكرهها، وقد
جعلت لها الشورى في نفسها، فدخلا عليها، وأعلماها بالذي رضيه إن رضيت هي، وبطلاق
عبد الله بن سلام امرأته أرينب، طلابا لمسرّتها، وذكرا من فضله، وكمال مروءته،
وكريم محتده، ما القول يقصر عن ذكره. فقالت لهما:
جفّ القلم بما هو كائن، وإنّه في قريش لرفيع، غير أنّ الله} يتولى تدبير الأمور في خلقه، وتقسيمها بين عباده، حتّى ينزلها منازلها فيهم، ويضعها على ما سبق في أقدارها. وليست تجري لأحد على ما يهوى، ولو كان لبلغ منها غاية ما شاء. وقد تعرفان أنّ التزويج هزله جدّ، وجدّه ندم، الندم عليه يدوم، والمعثور فيه لا يكاد يقوم، والأناة في الأمور أوفق لما يخاف فيها من المحذور، فإنّ الأمور إذا جاءت خلاف الهوى بعد التأني فيها، كان المرء بحسن العزاء خليقاً، وبالصبر عليها حقيقاً، وعلمت أنّ الله ولي التدابير. فلم تلم النفس على التقصير، وإنّي بالله أستعين، سائلة عنه، حتّى أعرف دخيلة خبره، ويصحّ لي الّذي أريد علمه من أمره ومستخيرة، وإن كنت أعلم أنّه لا خيرة لأحد فيما هو كائن، ومعلمتكما بالذي يرينيه الله في أمره، ولا قوّة إلّا بالله.
فقالا: وفقك الله وخار لك. ثمّ انصرفا عنها، فلما أعلماه بقولها تمثل وقال:
|
فإن يك صدر هذا اليوم ولىّ |
وتحدث الناس بالذي كان من طلاق عبد الله امرأته قبل أن يفرغ من طلبته، وقبل أن يوجب له الّذي كان من بغيته، ولم يشكوا في غدر معاوية إياه.
فاستحث عبد الله بن سلام أبا هريرة وأبا الدرداء، وسألهما الفراغ من أمره، فأتياها. فقالا لها: قد أتيناك لما أنت صانعة في أمرك، وإن تستخيري الله يخر لك فيما تختارين، فإنّه يهدي من استهداه، ويعطي من اجتداه، وهو أقدر القادرين. قالت: الحمد الله أرجو أن يكون الله قد خار لي، فإنّه لا يكل إلى غيره من توكل عليه، وقد استبرأت أمره، وسألت عنه فوجدته غير ملائم ولا موافق لما أريد لنفسي، مع اختلاف من استشرته فيه، فمنهم الناهي عنه، ومنهم الآمر به، واختلافهم أوّل ما كرهت من الله. فعلم عبد الله أنّه خدع، فهلع ساعة واشتد عليه الهم. ثمّ انتبه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وقال متعزياً: ليس لأمر الله راد، ولا لما لا بدّ أن يكون منه صاد، أمور في علم الله سبقت، فجرت بها أسبابها، حتّى امتلأت منها أقرابها، وإن امرؤ انثال له حلمه واجتمع له عقله، واستذله رأيه، ليس بدافع عن نفسه قدراً ولا كيداً، ولا انحرافاً عنه ولا حيداً، ولآل ما سروا به واستجذلوا له لا يدوم لهم سروره، ولا يصرف عنهم محذوره.
قال: وذاع أمره في الناس وشاع، ونقلوه إلى الأمصار، وتحدثوا به في الأسمار، وفي الليل والنهار، وشاع في ذلك قولهم، وعظم لمعاوية عليه لومهم، وقالوا:
خدعه معاوية حتّى طلق امرأته، وإنّما أرادها لابنه، فبئس من استرعاه الله أمر عباده، ومكنه في بلاده، وأشركه في سلطانه، يطلب أمراً بخدعة من جعل الله إليه أمره، ويحيره ويصرعه جرأة على الله. فلما بلغ معاوية ذلك من قول الناس.
قال: لعمري ما خدعته. قال: فلما انقضت أقراؤها، وجه معاوية أبا الدرداء إلى العراق خاطباً لها على ابنه يزيد، فخرج حتّى قدمها، وبها يومئذ الحسين بن علي وهو سيّد أهل العراق فقهاً ومالاً وجوداً وبذلاً. فقال أبو الدرداء إذ قدم العراق: مما ينبغي لذي الحجا والمعرفة والتقى أن يبدأ به ويؤثره على مهمّ أمره، لما يلزمه حقه، ويجب عليه حفظه، وهذا ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسيّد شباب أهل الجنة يوم القيامة، فلست بناظر في شيء قبل الإلمام به والدخول عليه، والنظر إلى وجهه الكريم وأداء حقه، والتسليم عليه، ثمّ أستقبل بعد إن شاء الله ما جئت له، وبعثت إليه، فقصد حتّى أتى الحسين، فلما رآه الحسين قام إليه فصافحه إجلالاً له، ومعرفته لمكانه من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وموضعه من الإسلام. ثمّ قال الحسين: مرحباً بصاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)وجليسه، يا أبا الدرداء، أحدثت لي رؤيتك شوقاً إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأوقدت مطلقات أحزاني عليه، فإنّي لم أر منذ فارقته أحداً كان له جليساً، وإليه حبيباً، إلّا هملت عيناي، وأحرقت كبدي أسى عليه، وصبابة إليه. ففاضت عينا أبي الدرداء لذكر رسول الله، وقال: جزى الله لبانة أقدمتنا عليك، وجمعتنا بك خيراً. فقال الحسين: والله إنّي لذو حرص عليك، ولقد كنت بالاشتياق إليك. فقال أبو الدرداء: وجهني معاوية خاطباً على ابنه يزيد أرينب بنت إسحاق، فرأيت أن لا أبدأ بشيء قبل إحداث العهد بك، والتسليم عليك. فشكر له الحسين ذلك، وأثنى عليه وقال: لقد كنت ذكرت نكاحها، وأردت الإرسال إليها بعد انقضاء أقرائها، فلم يمنعني من ذلك إلّا تخيير مثلك، فقد أتى الله بك، فاخطب رحمك الله عليّ وعليه، فلتختر من اختاره الله لها وإنّها أمانة في عنقك حتّى تؤديها إليها، وأعطها من المهر مثل ما بذل لها معاوية عن ابنه. فقال أبو الدرداء: أفعل إن شاء الله، فلما دخل عليها قال لها: أيتها المرأة إنّ الله خلق الأمور بقدرته، وكونها بعزته، فجعل لكل أمر قدراً، ولكل قدر سبباً، فليس لأحد عن قدر الله مستحاص، ولا عن الخروج عن علمه مستناص، فكان مما سبق لك وقدر عليك، الّذي كان من فراق عبد الله بن سلام إياك، ولعل ذلك لا يضرك، وأن يجعل الله لك فيه خيراً كثيراً. وقد خطبك أمير هذه الأمة، وابن الملك، ووليّ عهده، والخليفة من بعده، يزيد بن معاوية. وابن بنت رسول الله(صلى الله عليه وسلم)، وابن أوّل من آمن به من أمته، وسيّد شباب أهل الجنة يوم القيامة، وقد بلغك سناهما وفضلهما، وجئتك خاطباً عليهما، فاختاري أيهما شئت؟ فسكتت طويلاً. ثمّ قالت: يا أبا الدرداء لو أنّ هذا الأمر جاءني وأنت غائب عنّي أشخصت فيه الرسل إليك، واتبعت فيه رأيك، ولم أقطعه دونك على بعد مكانك، ونأي دارك، فأمّا إذ كنت المرسل فيه فقد فوّضت أمري بعد الله إليك، وبرئت منه إليك، وجعلته في يديك، فاختر لي أرضاهما لديك، والله شهيد عليك، واقض فيه قضاء ذي التحرّي المتقي، ولا يصدنك عن ذلك اتباع هوى، فليس أمرهما عليك خفياً وما أنت عما طوّقتك عمياً. فقال أبو الدرداء: أيتها المرأة إنّما عليّ إعلامك وعليك الاختيار لنفسك. قالت: عفا الله عنك، إنّما أنا بنت أخيك، ومن لا غنى بها عنك فلا يمنعك رهبة أحد من قول الحق فيما طوّقتك، فقد وجب عليك أداء الأمانة فيما حملتك، والله خير من روعي وخيف، إنّه بنا خبير لطيف. فلما لم يجد بدّا من القول والإشارة عليها.
قال: بنيّة، ابن بنت رسول الله أحبّ إليّ وأرضاهما عندي، والله أعلم بخيرهما لك، وقد كنت رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واضعاً شفتيه على شفتي الحسين فضعي شفتيك حيث وضعهما رسول الله، قالت: قد اخترته ورضيته، فاستنكحها الحسين بن عليّ، وساق إليها مهراً عظيماً، وقال الناس وبلغ معاوية الّذي كان من فعل أبي الدرداء في ذكره حاجة أحد مع حاجته، وما بعثه هو له، ونكاح الحسين إياها، فتعاظمه ذلك جدّاً، ولامه لوماً شديداً، وقال:
من يرسل ذا بلاهة وعمى، يركب في أمره خلاف ما يهوى، ورأيي كان من رأيه أسوأ، ولقد كنّا بالملامة منه أولى حين بعثناه، ولحاجتنا انتخلناه، وكان عبد الله بن سلام قد استودعها قبل فراقه إياها بدرات مملوءة دراً، كان ذلك الدرّ أعظم ماله وأحبه إليه، وكان معاوية قد أطرحه، وقطع جميع روافده عنه، لسوء قوله فيه، وتهمته إياه على الخديعة، فلم يزل يجفوه ويغضبه، ويكدي عنه، ما كان يجديه، حتّى عيل صبره، وطال أمره، وقلّ ما في يديه، ولام نفسه على المقام لديه، فخرج من عنده راجعاً إلى العراق، وهو يذكر ماله الّذي كان استودعها، ولا يدري كيف يصنع فيه، وأنّى يصل إليه، ويتوقع جحودها عليه، لسوء فعله بها، وطلاقه إياها على غير شيء أنكره منها، ولا نقمة عليها. فلما قدم العراق لقي الحسين، فسلّم عليه. ثمّ قال: قد علمت جعلت فداك الّذي كان من قضاء الله في طلاق أرينب بنت إسحاق، وكنت قبل فراقي إياها قد استودعتها مالاً عظيماً درّاً وكان الّذي كان ولم أقبضه، ووالله ما أنكرت منها في طول ما صحبتها فتيلاً، ولا أظنّ بها إلّا جميلاً، فذكّرها أمري، واحضضها على الرد عليّ، فإنّ الله يحسن عليك ذكرك، ويجزل به أجرك. فسكت عنه. فلما انصرف الحسين إلى أهله، قال لها: قدم عبد الله بن سلام وهو يحسن الثناء عليك، ويحمل النشر عنك، في حسن صحبتك، وما أنسه قديماً من أمانتك فسرّني ذلك وأعجبني، وذكر أنّه كان استودعك مالاً قبل فراقه إياك، فأدّي إليه أمانته، وردي عليه ماله، فإنّه لم يقل إلّا صدقاً، ولم يطلب إلّا حقاً. قالت:
صدق، قد والله استودعني مالاً لا أدري ما هو، وإنّه لمطبوع عليه بطابعه ما أخذ منه شيء إلى يومه هذا، فأثنى عليها الحسين خيراً، وقال: بل أدخله عليك حتّى تبرئي إليه منه كما دفعه إليك. ثمّ لقي عبد الله بن سلام، فقال له: ما أنكرت مالك، وزعمت أنّه لكما دفعته إليها بطابعك، فادخل يا هذا عليها، وتوفّ مالك منها. فقال عبد الله بن سلام: أو تأمر بدفعه إليّ جعلت فداك. قال: لا، حتّى تقبضه منها كما دفعته إليها، وتبرئها منه إذا أدّته. فلما دخلا عليها قال لها الحسين: هذا عبد الله بن سلام، قد جاء يطلب وديعته، فأدّيها إليه كما قبضتها منه، فأخرجت البدرات فوضعتها بين يديه، وقالت له: هذا مالك، فشكر لها، وأثنى عليها، وخرج الحسين، ففض عبد الله خاتم بدره، فحثا لها من ذلك الدرّ حثوات، وقال: خذي، فهذا قليل منّي لك، واستعبرا جميعاً، حتّى تعالت أصواتهما بالبكاء، أسفا على ما ابتليا به، فدخل الحسين عليهما وقد رقّ لهما، للذي سمع منهما. فقال: أشهد الله أنّها طالق ثلاثاً، اللَّهمّ إنّك تعلم أنّي لم أستنكحها رغبة في مالها ولا جمالها، ولكني أردت إحلالها لبعلها، وثوابك على ما عالجته في أمرها، فأوجب لي بذلك الأجر، وأجزل لي عليه الذخر إنّك على كل شيء قدير، ولم يأخذ مما ساق إليها في مهرها قليلاً ولا كثيراً. وقد كان عبد الله بن سلام سأل ذلك أرينب، أي التعويض على الحسين، فأجابته إلى ردّ ماله عليه شكراً لما صنعه بهما، فلم يقبله، وقال: الّذي أرجو عليه من الثواب خير لي منه فتزوّجها عبد الله بن سلام، وعاشا متحابين متصافيين حتّى قبضهما الله، وحرّمها الله على يزيد. والحمد لله ربّ العالمين»([715]).
الإشكالات التي أُوردت على القصة
أشير في مواضع من القصة إلى كلام سيّد الشهداء× يمكن أن يستفاد منها بعض الملاحظات في مواضيع مختلفة ولكن هذه القصة قد واجهت إشكالات. وإن كنّا لم نكتف بمجرد وجود كلام الإمام في هذه القصة، وأوردنا ما يؤيد هذا المضمون من الروايات الأخرى في المواضيع التي تمّ استخراجها منها. وهنا نتعرّض لمناقشة هذه الإشكالات.
قيل: الاختلافات الكثيرة بين أجزاء القصة، الأمر الذي يجعلها تواجه تشكيكاً شديداً، من قبيل:
أ) الاختلاف في اسم المرأة: أرينب، هند، أمّ خالد، زينب.
ب) الاختلاف في الزوج: عبد الله بن سلّام، عبد الله بن عامر.
ج) الاختلاف في الرسول (الواسطة): أبو الدرداء، أبو هريرة.
د) الاختلاف في الزوج الجديد: الإمام الحسن×، الإمام الحسين×([716]).
أوّلاً: إنّ هذا الاختلاف يمكن أن يرجع إلى شخص واحد على هذا النحو (أُرينب) لقبها و(هند) اسمها و(أم خالد) كنيتها.
ثانياً: يحتمل أن يكون عبد الله بن سلام تصحيف عبد الله بن عامر، ولذا من ناحية تاريخية يظهر أنّ الاسم الثاني أقرب إلى الواقع، على الخصوص أنّه لم يذكر أنّ شخصاً باسم عبد الله بن سلام قد نصب والياً على العراق من قبل معاوية كما أشير إلى ذلك في الإشكال الآخر.
ثالثاً: الظاهر أنّ الشخص الواسطة هو أبو هريرة الذي ورد في بعض التواريخ، بنفس الدليل الذي قد ذكر على أنّه إشكال ثان.
رابعاً: الزوج الجديد أياً كان فهو الإمام المعصوم وسنته حجّة وعلى تقدير أنّه سيّد الشهداء× فقد أشرنا إلى الملاحظات التي تستفاد من كلامه في هذه الموسوعة.
خامساً: بالرغم من أنّ الاضطراب في علم الحديث والدراية من أسباب ضعف النص، ولكن الاضطراب الموجود في قصة أرينب ليس فاحشاً وكبيراً بحيث يمكن ردّه لهذه القصة بسهولة.
سادساً: بما أنّه قد وقع الاختلاف بخصوص شخصيات القصة المذكورة في كثير من الكتب؛
لذا فمن الممكن تأييد مضمون هذه القصة من خلال الشواهد،
لا سيما وأنّ جميع الروايات التاريخية متفقة بخصوص أصل هذه القصة وانحسر الاختلاف
في التفاصيل وأسماء الأشخاص.
قيل: إنّ أبا الدرداء ـ الذي ذُكر اسمه في بعض المصادر التاريخيّة على أنّه رسول معاوية في هذه القصة ـ توفّي في زمان خلافة عثمان (23 ـ 34 ﻫ) طبقاً لبعض النقول التاريخيّة، أو توفّي في إحدى السنوات التالية: 31، 32، 33، 34، 38، 39 من الهجرة. والرأي المشهور في وفاته أنّها كانت في زمان خلافة عثمان، وحتّى لو فرضنا أنّه قد مات عام 39 ﻫ فلا يمكن ـ أيضاً ـ تصديق دوره المذكور في القصة؛ ذلك أنّ القصة وقعت على ما يبدو بعد أخذ معاوية البيعة ليزيد، أي عام 49 ﻫ.
ومن جانب آخر، كيف يمكن ليزيد المولود ـ كما قالوا ـ عام 31 أو 27 أو 26 أن يعشق امرأة وهو في سنّ الثانية عشرة من عمره على أقصى التقادير، بناءً على أنّ أبا الدرداء قد توفّي عام 39 ﻫ؟!([717])
أوّلاً: كما قلنا في نقد الإشكال الأوّل أنّ هذا الإشكال يمكن أن يكون قرينة على أنّ أبا هريرة هو الوسيط في هذا الزواج، كما ورد ذلك في بعض الروايات.
ثانياً: قد جاء في هذا الإشكال أنَّ المشهور في وفاة أبي الدرداء أنّها حصلت في زمن خلافة عثمان. ويفهم من هذا الكلام وجود رواية أخرى تتعلق بزمن وفاته.
قيل: لم تذكر المصادر التاريخيّة تولّي عبد الله بن سلام حكم العراق من جانب معاوية.
وفضلًا عن ذلك، فإنّ اسم عبد الله بن سلام قد جاء في الكتب التاريخيّة لأشخاص ثلاثة، ولد اثنان منهما بعد وقوع هذه الحادثة، والوحيد من بينهم الذي يمكن أن يكون موجوداً خلال أيام الحادثة هو عبد الله بن سلام اليهودي، إلّا أنّه لا يمكن أن يكون هو المراد أيضاً؛ وذلك أنّه توفّي عام 41 أو 43 ﻫ، وقد كان في تلك الفترة شيخاً عجوزاً مسنّاً([718]).
كما قلنا سابقاً بما أنّ هناك تشابهاً بين اسم عبد الله بن سلام واسم عبد الله بن عامر من حيث التلفظ، فيحتمل التصحيف.
قيل: إنّ قصد مختلقي هذه القصة هو أنّهم يرومون من ورائها أن يصوّروا أسباب ثورة الإمام الحسين× ضدّ يزيد بأنّها أسباب ترجع إلى نزاعات جاهليّة، وأنّها في نطاق الشجار الشخصي القائم على الأهواء النفسيّة؛ وذلك كي يقلّلوا من شأنه، فكانت النقول التاريخيّة الضعيفة خير موضع لدسّ مثل هذه المختلقات([719]).
أوّلاً: لم تتم الإشارة في هذه القصة إلى هذا الأمر وأنّ هذه القصة هي السبب في مقتل الإمام الحسين× من قبل يزيد بن معاوية، كما لا يوجد أيّ خبر من هذا القبيل يشير إلى هذا المدعى، وبالتالي فليس هذا المدعى إلّا مجرد احتمال.
ثانياً: إنّ هذا الادعاء يضرّ يزيد بن معاوية أكثر دون الإمام الحسين× وثورته؛ لأنّه يدل على أنّ يزيد قتل سيّد الشهداء× لأجل حجج واهية.
ثالثاً: إذا كان سبب محاربة يزيد للإمام الحسين× هو هذه القصة، فلماذا لم يقتل الإمام الحسين× قبل خروجه؟! نعم إنّ من قرأ قصة الإمام الحسين× سنة 61 هجري وخروجه يدرك جيداً أنّ سبب مواجهة يزيد واهتمامه بقتل الحسين× لم يكن إلّا خروج الإمام× ضدّ يزيد بن معاوية.
رابعاً: إنّ هذه القصة تشير إلى قمة وعي وبصيرة الإمام الحسين×، وكيف تمكن من خلال تدبير حكيم إنقاذ امرأة ورجل من كيد معاوية ويزيد وحيلهما، ومنعهما من الوصول إلى أهدافهما المشؤومة.
خامساً: فإن كان من المفترض أن يناقش أصل هذه القصة بهذه المناقشة،
فلا بدّ أن ينجر الكلام إلى الأخبار والمنقولات المشابهة له أيضاً.
نقل ابن سعد بسنده عن المسور أنّه قال:
«أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى مَرْوَانَ: زَوِّجْ يَزِيدَ مِنْ ابْنَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَاقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ خَمْسِينَ أَلْفَ دِينَارٍ وَصِلْهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِينَارٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ: مَا أَقْطَعُ أَمْراً دُونَ الْحُسَيْنُ. فَشَاوَرَهُ فَقَالَ: اجْعَلْ أَمْرَهَا إِلَيَّ فَفَعَلَ. وَاجْتَمَعُوا فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ الْقَرَابَةَ لُطْفاً، وَالْحَقَّ عِظَماً، وَأَنْ يَتَلَافَى صَلَاحَ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ بِالْصِّهْرِ، وَقَدْ كَانَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي إِجَابَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا حَسَّنَ فِيهِ رَأْيُهُ وَوَلِيُّ أَمْرِهَا خَالُهَا، وَلَيْسَ عِنْدَ حُسَيْنٍ خِلَافٌ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ.
فَتَكَلَّمَ حُسَيْنٌ وَقَالَ: إِنَّ اللهَ رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ وَأَتَمَّ النَّاقِصَةَ، وَأَذْهَبَ اللَّوْمَ، فَلَا لَوْمَ عَلَى مُسْلِمٍ، وَإِنَّ الْقَرَابَةَ الَّتِي عَظَّمَ اللهُ حَقَّهَا قَرَابَتُنَا وَقَدْ زَوَّجْتُ هَذِهِ الْجَارِيَةَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ نَسَباً وَأَلْطَفُ سَبَباً الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. فَقَالَ مَرْوَانُ: أَغَدْراً يَا بَنِي هَاشِمٍ؟ وَقَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ: يَا بْنَ جَعْفَرٍ مَا هَذِهِ أَيَادِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ! قَالَ: قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنِّي لَا أَقْطَعُ أَمْراً فِيهَا دُونَ خَالِهَا. فَقَالَ حُسَيْنٌ: نَشَدْتُكُمُ اللهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَسَنَ خَطَبَ عَائِشَةَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَوَلَّوْكَ أَمْرَهَا فَلَمَّا صِرْنَا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَجْلِسِ قُلْتَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُزَوِّجَهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ؟ هَلْ كَانَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ ـ يَعْنِي الْمِسْوَرَ بْنَ مِخْرَمَةَ ـ فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنَّما أَلْوَمُ عَبْدَ اللهِ، فَأَمَّا حُسَيْنٌ فَوَغِرُ الصَّدْرِ. فَقَالَ مِسْوَرْ: لَا تُحْمَلُ عَلَى الْقَوْمِ، فَالَّذِي صَنَعُوا أَوْصَلَ، وَصَلُوا رَحِماً وَوَضَعُوا كَرِيمَتَهُمْ حَيْثُ أَحَبُّوا»([720]).
قيل: ومن جهة أخرى، فإنّ صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد لا تنسجم مع فقه أهل البيت^؛ فقد ردّ ذلك فقهاء الشيعة بالإجماع([721]).
أوّلاً: لعل الطلاق ثلاث مرات من جهة الإيقاع على طبق المخاطب الذي هو من أتباع الخلفاء لا سيما عمر بن الخطاب الذي كان يرى أنّ الطلاق ثلاث مرات في مجلس واحد جائز، وفي الحقيقة أنّ مقصود الإمام من الطلاق ثلاث مرات الإشارة إلى عدم الرجوع إليه؛ كي يقطع أمله من أُرينب وترجع بسهولة إلى زوجها السابق.
ثانياً: لعل مقصود الإمام× (أنّها طالق ثلاثاً) الطلاق بعد ثلاثة أطهار، وذلك لأنّ الطلاق لا بدّ أن يكون بعد ثلاثة أطهار.
ثالثاً: الاحتمال الآخر في جملة: «أشهد الله أنّها طالق ثلاثاً»، وهي أن يكون المقصود من هذه الجملة الإخبار لا الإنشاء، فالإمام كان بصدد الإخبار عن هذا الأمر بأنّ أرينب قد طلقها في ثلاثة مجالس.
رابعاً: وإن كان من وجهة نظر مشهور الفقهاء أنّ الطلاق ثلاث مرات باطل ولكنهم لم يقولوا ببطلان الطلاق ثلاث مرات، بل يعتبرونه بحكم الطلاق مرة واحدة، ولذا لا يمكن أن يدعى بأنّ الطلاق الذي أنشأه الإمام الحسين× كان باطلاً بالكلية.
بعض فقهاء السنّة وعامة فقهاء الشيعة وبالرغم من أنّهم أفتوا بأنّ الطلاق ثلاث مرات محرم وبدعة ولكنهم يعدونه بحكم الطلقة الواحدة، نظير طلاق الظهار فإنّه وإن كان باطلاً ولكن تترتب عليه أحكام من جملتها الكفارة. وهنا نتعرض إلى كلمات علماء الفريقين:
فتاوى علماء الشيعة
قال الشيخ الطوسي في (الخلاف):
«إذا طلقها ثلاثاً بلفظ واحد، كان مبدعاً، ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا»([722]).
وقال صاحب (جواهر الكلام):
«وقيل والقائل المشهور بل عن المرتضى في (الناصريات) ما يشعر بالإجماع عليه، وكذا عن (الخلاف)، بل عن العلامة في (نهج الحق) ذلك صريحاً، يقع طلقة واحدة بقوله: (طالق)، ويلغو التفسير بالثلاث، فلا ينافي ترتب الوحدة على نفس الصيغة المقتضية لذلك. وهو أشهر الروايتين عملاً كما عرفت، بل قيل: ورواية...»([723]).
فتاوى السنّة
قال ابن الهمام:
«وقال قوم: يقع به واحدة، وهو مروي عن ابن عباسE، وبه قال ابن إسحاق. ونقل عن طاوس وعكرمة أنّهم يقولون خالف السنّة فيرد إلى السنّة»([724]).
قال ابن تيمية بشأن الأقوال في المسألة:
«الثالث: أنّه محرم ولا يلزم منه إلّا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس بن عمرو ومحمّد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه، ويروى ذلك عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمّد؛ ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل»([725]).
وقال ابن قيم الجوزية:
«الثالث: أنّه يقع به واحدة رجعية... وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية»([726]).
وقال المرداوي:
«وحكى عدم وقوع الطلاق الثلاث جملة، بل واحدة في المجموعة أو المتفرقة عن جدّه المجد، وأنّه كان يفتي به أحياناً سراً»([727]).
وقال ابن قيم الجوزية:
«إنّ المطلق في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) وزمن خليفته أبي بكر وصدراً من خلافة عمر كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت واحدة... وكل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أنّ الثلاث واحدة فتوى أو إقراراً أو سكوتاً، ولهذا ادعى بعض أهل العلم أنّ هذا إجماع قديم، ولم تجمع الأمة ولله الحمد على خلافه، بل لم يزل فيهم من يفتي به قرناً بعد قرن، وإلى يومنا هذا...»([728]).
القائلون بوحدة الطلاق
يعتقد جماعة من الصحابة والتابعين وعلماء أهل السنّة بأنّ الطلقات الثلاث في مجلس واحد بحكم الطلقة الواحدة.
قال محمّد بن علي الشوكاني بهذا الصدد:
«واعلم أنه قد وقع الخلاف في الطلاق إذا أوقعت في وقت واحد، هل يقع جميعها ويتبع الطلاق الطلاق أم لا؟ فذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة وطائفة من أهل البيت منهم أمير المؤمنين علي والناصر والإمام يحيى، حكى ذلك عنهم في البحر، وحكاه أيضا عن بعض الإمامية إلى أن الطلاق يتبع الطلاق. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يتبع الطلاق بل يقع واحدة فقط. وقد حكى ذلك صاحب البحر عن أبي موسى ورواية عن علي× وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والباقر والناصر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى بن عبد الله ورواية عن زيد بن علي، وإليه ذهب جماعة من المتأخرين منهم ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين. وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار، وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن عليE وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير»([729]).
أدلة وقوع الطلقة الواحدة
لقد تمسك من أفتى بوقوع الطلقات الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة بأدلة نشير فيما يلي إلى بعضها:
أ) آية القروء الثلاثة
قال الله تعالى:
(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ([730])
ونقرأ في الآية الأخرى:
(الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) ([731])
الألف واللام في الآية الثانية عهدية والمعهود هو الطلاق المذكور في الآية المتقدمة، فيكون معنى الآية الكريمة أنّ الطلاق الذي يكون للزوج الحق بردّها مرتين، ولا فرق في ذلك بين أن يوقع الطلاق في مجلس واحد طلقة أو ثلاث طلقات.
ب) أصالة بقاء العقد
حينما يقول الزوج: «زوجتي فلانة طالق»يتحقق بذلك طلقة واحدة، ولكن حينما يضم إليها قوله: (ثلاثاً) هنا يقع البحث هل أنّ هذه الكلمة تبطل إيقاع الطلاق أو أنّه يقع ثلاث طلقات؟ المسلّم به هو وقوع طلاق واحد في زمن واحد وبالنحو الصحيح، والأكثر من ذلك مشكوك فيه فنستصحب بقاء طلقة واحدة.
ج) حديث ابن عباس
قال ابن عباس:
«كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً.
فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ»([732]).
وقد أورد على حديث ابن عباس عدة إشكالات وأجاب عنها ابن القيم الجوزية.
حيث يفهم من هذا الحديث أنّ وقوع ثلاث طلقات على صيغة الطلاق ثلاث مرات من بدع عمر بن الخطاب، ولا دليل على حجية اجتهاده، لا سيما وأنّ اجتهاده كان في مقابل النص.
د) حديث عبد اللّه بن عمر
روي أنّ عبد الله بن عمر قد طلّق امرأته في حال الحيض ثلاث طلقات، فأمره رسول الله| بالرجوع إليها([733]).
وهذا نص في صحة طلاق واحد؛ لأنّه لو كان قد وقعت ثلاث طلقات فلا يحق له الرجوع إليها.
هـ) قصة طلاق ركانة
روى عكرمة عن ابن عباس أنّه قال:
«طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو بَنِي المطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً، قَالَ: فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟) قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً، قَالَ: فَقَالَ: (فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ)»([734]).
و) روايات أهل البيت^
روي عن الإمام الصادق× أنّه قال:
«الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»([735]).
وبهذا المضمون قد وردت روايات كثيرة من طرق أهل البيت^.
ز) الإجماع
كما أشرنا أنّ إجماع الصحابة كان قائماً حتّى عصر خلافة عمر على وقوع طلقة واحدة.
قيل: إنّ أوّل ما يطالعنا في هذه القصة أنّها تظهر أنّ يزيد يعتقد بأنّ أباه يعلم الغائبات، ومنها ما يخفي صدر ولده من عشق هذه المرأة أو تلك ([736]).
من أين يُعلم أنّ معاوية لم يطلع على عشق يزيد لتلك المرأة من الطرق المتعارفة ولم يفهم الحالات التي طرأت على ولده يزيد حينما رأى أُرينب أو سمع بوصفها؟ لأنّه لم يرد في تلك القصة كلام حول علم الغيب.
قيل: إنّ من يقرأ هذه القصة يخرج بانطباع لا حقيقة له عن البيت السفياني فإنّها تظهر أنّ هذا البيت بيت علم ودين، وحلم وقيم، وأخلاق، وبيت حكمة، وتقوى، والتزام واستقامة، وعقل، ودراية...([737]).
أوّلاً: من لديه إلمام بكل الرواية يفهم أنّ جميع هذه الصفات لأهل بيت النبي| ومن جملتهم الإمام الحسين× حيث أرجع زوجة إلى زوجها الحقيقي بهذه الخطة الحكيمة ومنع يزيد بن معاوية الطامع من الوصول إلى نزواته وأهوائه النفسية وهذا الأمر يدركه جيداً من لديه معرفة بالنفوس.
ثانياً: كيف تدل هذه القصة على مدح آل أبي سفيان، والحال أنّ معاوية يصف ولده بصفات مذمومة كترك التقوى وعدم المروءة والعقل.
الإشكال الثامن
قيل: فإنّ كلمات معاوية، وكذلك ابنته التي تضمنتها هذه الرواية تفوح منها رائحة الترويج لعقيدة الجبر الإلهي([738]).
بما أنّ الجبر باطل كالتفويض وهو مخالف للعقل والقرآن والروايات، فيشكّل هذا الأمر من جملة الشواهد الدالة على القدح في آل أبي سفيان ومن جملتهم معاوية ويزيد وهي على عكس الإشكال أدل.
قيل: نجد هذه الرواية تقول: إنّ معاوية قال ليزيد: أين حجاك، ومروءتك وتقاك؟! فأجابه يزيد: «لو كان أحد ينتفع فيما يبتلى به من الهوى بتقاه، أو يدفع ما أقصده بحجاه، لكان أولى الناس بالصبر داود×، وقد خبرك القرآن بأمره»([739]).
إذا كان قد نسب هذا الأمر إلى المعصوم لأوجب ذلك وهن هذه القصة، في حين أنّه قد نسب هذا الأمر إلى يزيد بن معاوية، وهذا يدل على جهله وعدم اطلاعه بالقرآن والأنبياء؛ ولذا فلا يمكن أن نعتبر كلامه دليلاً على بطلان هذه القصة، وإن كان كلامه باطلاً.
قيل: وقد ادعت الرواية أنّ أرينب كانت مثلاً في أهل زمانها في جمالها، وتمام كمالها وشرفها، وكثرة مالها.
ولا ندري كيف خفي هذا الأمر عن المؤرخين، والأدباء والشعراء، والكتّاب، فلم يذكروها في أشعارهم، ولا في تواريخهم، وقصصهم، ورواياتهم([740]).
الظاهر أنّ نساء العرب الجميلات على طائفتين: الطائفة الأولى: النساء الجميلات غير العفيفات اللاتي يبدين زينتهن، وهذه الطائفة عادة يرد ذكرها في الكتب والأشعار ويتعرض الأدباء إلى وصفهن، والطائفة الأخرى من نساء العرب بسبب عفافهن لا يجرء الشعراء على ذكر اسمهن أو وصفهن، ومن المحتمل أن تكون أرينب من الطائفة الثانية.
قيل: وقد أطرى معاوية نفسه، وأعطاها مقامات وصلاحيات لا تليق بغير الأنبياء وأوصيائهم، وبعضها لا يليق بغير رسول الله محمّد|، أو بمن نص القرآن على أنّه نفس محمّد| ([741]).
هذه القرينة تدل على ذم معاوية وعقيدته وأفكاره، ولا يدل على بطلان أصل القصة.
قيل: أمّا ما نسبته الرواية من ثناء لأبي الدرداء وأبي هريرة على معاوية، بادّعاء أنّ معاوية أولى الناس برعاية نعم الله وشكرها؛ «لأنّه صاحب رسول الله| وكاتبه». فهو عجيب أيضاً...([742]).
وإن كان ادّعاء أبي الدرداء وأبي هريرة بحق معاوية باطلاً، لكن صدور هذا الأمر منهما غير بعيد، لا سيما إن كان من باب التقية أو الخوف من معاوية أو التزلف إليه، إلّا أنّ صدور هذا الأمر منهما لا يدل على بطلان أصل القصة؛ وذلك لأنّهما غير معصومين حتّى يتوجب إنكار القصة حفاظاً على عصمتهم.
وقيل في خصوص انتشار خبر حيلة معاوية بالنسبة إلى ابن سلام: وتدعي الرواية شيوع وذيوع هذا الأمر في الناس، «ونقلوه إلى الأمصار، وتحدثوا به في الأسمار، وفي الليل والنهار».
وسؤالنا هو: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يذكر المؤرخون والرواة والمؤلفون والأدباء والشعراء هذه القضية؟!([743]).
أوّلاً: إنّ هذه القصة قد نقلها جملة من المؤلفين في كتبهم وهم كالتالي:
1ـ ابن قتيبة الدينوري (213 ـ 276 ق) في (الإمامة والسياسة)([744]).
2ـ ابن بدرون (ت 608 ق) في (شرح قصيدة ابن عبدون)([745]).
3ـ شهاب الدين النويري (677 ـ 733 ق) في (نهاية الأرب)([746]).
4ـ ابن حجة الحموي (767 ـ 837 ق) في (ثمرات الأوراق)([747]).
5ـ جمال الدين الشبراوي (1092 ـ 1172 ق) في (الإتحاف بحب الأشراف)([748]).
ثانياً: لعل سبب عدم ذكر أمثال الطبري في كتبه التاريخية؛ لدلالة هذه القصة على القدح في يزيد بن معاوية وفضيلة الإمام الحسين× كما صنعوا ذلك في مطاعن الخلفاء وفضائل أهل البيت^ كما حدث في أحاديث الوصاية. وبما أنّ اشتهار لقب (الوصي) لأمير المؤمنين× لا يناسب سياسة مدرسة الخلفاء؛ لذا فهم سعوا جاهدين لمواجهة هذه الأحاديث بالمقدار الممكن، ونشير هنا إلى بعض أنواع هذه المواجهة بالنسبة إلى نصوص الوصاية:
أ) الحذف والتغيير
من جملة أنواع هذه المواجهة حذف بعض الكلمات من حديث رسول الله| واستبدالها بكلمات مبهمة.
ونلاحظ هذا النوع من التحريف قد ورد في عبارات الطبري([749]) وابن كثير([750]) في تفسير الآية(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)([751])؛ وذلك لأنّه ورد في تفسير هذه الآية الكريمة كلام رسول الله| بحق الإمام علي× حيث قال: «إنّ هذا أخي ووصىي وخليفتي فيكم»([752])، وقد حذف الطبري وابن كثير كلمة وصيي وخليفتي واستبدلاها بكلمات أخرى بكلمة «كذا وكذا».
ب) حذف جميع الرواية
من جملة أنواع التضليل ومنع الأحاديث، حذف جميع الرواية مع الإشارة إلى الحذف.
من جملة الأمثلة التي يصلح ذكرها في هذا المجال كتاب محمّد بن أبي بكر إلى معاوية الذي ورد بشكل مفصل في كتاب (وقعة صفين)([753]) لنصر بن مزاحم و(مروج الذهب)([754]) للمسعودي، حيث قد أشار محمّد بن أبي بكر إلى فضائل الإمام علي× والتي من جملتها وصاية وخلافة الإمام عن النبي| واعتراف معاوية في جواب الكتاب بذلك.
ولكن الطبري حذف نصّ هذا الكتاب، ويعتذر عن عمله هذا بأنّ عامة الناس لا يتحملون سماع ذلك، حيث قال:
«وذكر هشام، عن أبي مخنف، قال: وحدثني يزيد بن ظبيان الهمداني، أنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما ولي، فذكر مكاتبات جرت بينهما كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة»([755]).
واكتفى ابن كثير أيضاً بالإشارة إلى كتاب محمّد بن أبي بكر وقال:
«وفيه غلظة»([756]).
ج) حذف من دون الإشارة
من ضمن السبل التي اتبعت لمواجهة أحاديث وأخبار (الوصاية) حذف عنوان الوصاية من دون الإشارة إلى ذلك، ومنها قصيدة الصحابي الأنصاري النعمان بن عجلان بشأن الأحداث التي جرت في السقيفة.
|
وقلتم: حرام نصب سعد ونصبكم فذاك بعون الله يدعو إلى الهدى |
حيث أنشأ قائلاً:
وقد ذكر ابن عبد البرّ في (الاستيعاب)([758]) القصيدة بتمامها عند ترجمته لنعمان بن عجلان، ولكنه حذف البيتين الأخيرين الذين أثنى بهما على الإمام علي× وصرّح فيهما بالوصاية. وقد حذف ابن الأثير الجزري هذين البيتين أيضاً في كتابه (أسد الغابة)([759]) عند ترجمته للشاعر، وكذا كل من جاء بعده، فقد ارتكب نفس هذا التحريف.
ومن الأمثلة الأخرى على هذا النوع من التحريف: ما ارتكبه ابن كثير في تاريخه بشأن خطبة الإمام الحسين×. حيث نقل الطبري وابن الأثير الخطبة كالتالي:
قال×:
«أَمَّا بَعْدُ فَانْسُبُونِي فَانْظُرُوا مَنْ أَنَا، ثُمَّ ارْجِعُوا أَنْفُسَكُمْ فَعَاتِبُوهَا وَانْظُرُوا هَلْ يَصْلُحُ وَيَحِلُّ لَكُمْ قَتْلِي وَانْتِهَاكُ حُرْمَتِي؟! ألَسْتُ ابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ وَابْنَ وَصِيِّهِ وَابْنِ عَمِّهِ...»([760]).
ولكن ابن كثير في تاريخه لما نقل هذه الخطبة حذف منها كلمة «وابن وصيّه»([761]).
د) حذف جميع الخبر من دون الإشارة إليه
من الطرق التي اتبعت لمواجهة أحاديث (الوصاية) حذف جميع الرواية التي ورد فيها لفظة الوصي من دون الإشارة إلى حذفها، ومن مصاديق ذلك ما قام به ابن هشام، فبالرغم من تصريحه في بداية كتابه بأنّه يروي الأحداث التاريخية عن سيرة ابن إسحاق إلّا أنّه لم ينقل قضية دعوة النبي| قومه بعد نزول الآية (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)وإبلاغهم وصاية الإمام علي×، والحال أنّ الطبري نقل هذه الرواية عن ابن إسحاق([762]).
قيل: وبالرغم من كل هذه التفاصيل التي ساقتها الرواية لعملية الغدر التي تقول الرواية: إنّ معاوية حبك خيوطها، نرى معاوية يقول: لعمري ما خدعته([763]).
إنّ هذا الأمر كافٍ في القدح بآل أبي سفيان وأبرزهم معاوية، وبما أنّ معاوية لم يكن معصوماً حتّى ندافع عنه؛ لذا فوجود هذا الأمر في هذه القصة لا يدلّ على بطلانها، وهي إنّما تدل على مثالب ومطاعن معاوية، ومن هنا نجد أنّ كثيراً من المؤرخين يحاولون إخفاء ذلك.
الإشكال الخامس عشر
قيل: وتعود الرواية لتقرر معنى الجبر من جديد حتّى على ألسنة الناس عامة... تقول الرواية: إنّ الناس قالوا عن معاوية:
«إنّ الله تعالى مكّنه في بلاده»([764]).
من يراجع تاريخ معاوية وحكام بني أمية يجد أنّ معاوية أوّل من قال بالجبر لأجل تجميد عقول الناس وقمع الثورات المناهضة له، ولا يوجد ثمّة استبعاد أن يكون إلقاء هذه الفكرة في عقول الناس من قبل معاوية ترويجاً وتبليغاً له، وقد تقبلها الناس وإن كانت باطلة من أساسها.
قيل: وتحدثت الرواية عن أنّ الإمام الحسين× قام لأبي الدرداء وصافحه إجلالاً له، ومعرفة منه لمكانه من رسول الله’، وموضعه من الإسلام، ولأنّه صاحب رسول الله| وجليسه([765]).
أوّلاً: إنّ أصحاب رسول الله| كانوا عدّة طوائف:
أ) من التبس عليهم الأمر وماتوا مرتدين، كما أشير إلى ذلك في أحاديث الحوض في صحيح البخاري وغيره من الكتب المهمّة عند السنّة.
قال ابن عباس:
«قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) خَطِيباً بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)([766]) أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الخلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ×، أَلَا وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي! فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: (وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ * إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) قَالَ: فَيُقَالُ لِي: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ»([767]).
ب) الذين لم يلتبس عليه الأمر وأصبحوا بعد رسول الله| من المدافعين عن أهل البيت^، ونشير هنا إلى نماذج منهم:
1 ـ المقداد بن الأسود
حيث قال:
«وا عجباً لقريش، ودفعهم هذا الأمر على أهل بيت نبيهم، وفيهم أوّل المؤمنين...»([768]).
والمقداد من الأركان الأربعة للشيعة، وهو من الفرقة المخلصة للإمام علي× في زمن النبي×.
2 ـ سلمان الفارسي
حيث خاطب الناس بعد واقعة السقيفة قائلاً:
«كرداذ وناكرداذ (أي عملتم وما عملتم)، لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم»([769]).
إنَّ سلمان من أصحاب الإمام علي× الثابتين، وهو أوّل الأصحاب الأربعة الشيعة الموالين للإمام علي×. إنّ صفاءه ودفاعه عن الإمام علي× لا ريب أنّه كان له الأثر البالغ في تمايل قومه إلى التشيع.
3 ـ أبو ذر الغفاري
حيث قال:
«أصبتم قناعه وتركتم قرابه، لو جعلتم هذا الأمر في أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان»([770]).
4 ـ أبو الهيثم بن التيهان
وكان بدرياً، حيث قال في حرب الجمل دفاعاً عن أمير المؤمنين×:
|
قل للزبير وقل لطلحة إنّنا |
أبو الهيثم كان أوّل من يمثل الأنصار في مبايعة علي×([772])، وبناء على أحد الأخبار استشهد في حرب صفين([773]).
5 ـ حجر بن عدي الكندي
جاء هو مع أخيه هاني بن عدي إلى رسول الله| فأسلما([774])، وكان إلى جنب علي× بعد رحيل رسول الله| حتّى عدّ من أصحابه الخلّص والأوفياء([775]).
شارك في حرب الجمل وصفين والنهروان مع علي×، وكان في حرب صفين قائداً على قبيلته (كندة) كما كان قائداً في حرب النهروان على الجناح الأيسر لجيش الإمام علي× ([776]).
وقال دفاعاً عن الإمام علي×:
|
يا ربنا سلّم لنا علياً ثمّ ارتضاه بعده وصيا([777]). |
6 ـ قيس بن سعد
سيّد الخزرج وهو صحابي عظيم، أنشأ في حرب صفين دفاعاً عن الإمام علي× قائلاً:
|
وعلي إمامنا وإمام |
7 ـ النعمان بن عجلان الأنصاري
قال في حرب صفين دفاعاً عن الإمام علي×:
|
كيف التفرق والوصي إمامنا |
ج) كان بعضهم حياديين، وبتعبير آخر يتبعون من يحقق مصالحهم، ويمكن أن يعدّ منهم على سبيل المثال عبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو الدرداء، وكان أهل البيت^ يتماشون مع هكذا أشخاص من أصحاب النبي|، وكانوا يحترمونهم من باب أنَّهم من أصحاب رسول الله| وإن لم يتمّ الإشارة في هذه القصة إلى الاحترام الخاص بأبي الدرداء، وإن كان هناك احترام فهو سطحي.
ثانياً: لقد استبعد في تكملة كلامه: كيف يكون أبو الدرداء صحابياً وجليساً لرسول الله| والحال أنّه كتم حديث «علي مع القرآن، والقرآن مع علي»أو «علي مع الحق، والحق مع علي، يدور معه حيث دار»، ولكن هذا الاستبعاد في غير محله؛ وذلك لأنّ بعض الصحابة الآخرين ممن جالس رسول الله| كانوا أيضاً من هذا النوع، حيث أنكروا كثيراً من فضائل الإمام علي× ومنهم أنس بن مالك، وقد ابتلاه الله} بمرض البرص بسبب كتمانه حديث الغدير.
طبقاً لبعض الروايات أنّ أمير المؤمنين× قد استشهد بعض من كان حاضراً من الصحابة في واقعة الغدير في جماعة من الصحابة كي ينهض ويشهد بحديث رسول الله| يوم غدير خم بين الجمع، فقام بعضهم وشهدوا بذلك، وامتنع بعض منهم من الإدلاء بالشهادة معتذراً بحجج واهية فابتلاهم الله تعالى بأمراض لا يمكن علاجها، ويمكن الإشارة إليهم أدناه:
1ـ أنس بن مالك؛ وقد ابتلي بسبب كتمانه حديث الغدير بمرض البرص([780]).
2ـ بُراء بن عازب؛ وقد ابتلي بالعمى بسبب كتمانه حديث الغدير([781]).
3ـ زيد بن أرقم؛ وهو أيضاً أصيب بالعمى بسبب كتمانه حديث الغدير([782]).
4ـ جرير بن عبد الله البجلي؛ وقد رجع إلى الجاهلية بعد كتمانه حديث الغدير ودعاء الإمام أمير المؤمنين× عليه([783]).
نعم هكذا استبعاد إذا كان قد صدر عن المعصوم فيجب حينئذ توجيه الحديث أو ردّه لا ما إذا صدر من أمثال أبي الدرداء، ومع وجود هذه الروايات ينبغي على أهل السنّة إعادة النظر في عقيدتهم بعدالة الصحابة.
قيل: وقد ذكرت الرواية أنّ أرينب بعد أن سمعت من أبي الدرداء أنّ الحسين× هو ابن بنت الرسول|، وابن أوّل من آمن، وهو سيّد شباب أهل الجنة يوم القيامة، تصر أن يكون أبو الدرداء هو الذي يخبرها بالأصلح منهما...
ولست أدري كيف لم تصدق هذه المرأة قول رسول الله} في الإمام الحسين×، ولم تأخذ به، ثمّ تبقى حائرة، ولا تستطيع أن تعرف من هو الأصلح بين الحسين الذي عرفت حاله، وبين يزيد الفاسق الفاجر، الشارب للخمر، وقاتل النفس المحترمة؟! ([784]).
أوّلاً: مع وجود الإعلام الأموي ضدّ أهل البيت^ والمدح للخلفاء فلا غرابة من هذا التحيّر الذي يصدر من امرأة كأرينب.
ثانياً: إنّ أُرينب وإن كانت تعلم بأنّ سيّد الشهداء× ابن رسول الله| لكن من أين لها العلم والاطلاع على فضائل الإمام الحسين×.
ثالثاً: هذا الإشكال إنّما يرد على أُرينب ولا يرد على أصل الرواية.
قيل: والذي يزيد الطين بلة، قول الرواية: إنّ الإمام الحسين× قال:
«اللّهم إنّك تعلم أنّي لم أستنكحها رغبة في مالها ولا جمالها، ولكني أردت إحلالها لبعلها».
فإنّ هذا الإحلال إنّما يكون إذا كان زوجها قد طلقها ثلاث طلقات، تخللتها رجعتان...
أمّا قول الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فيدور أمره بين احتمالين:
1ـ إمّا أن يكون باطلاً...
2ـ وإمّا أن يقع طلقة واحدة...
ولا تحرم المرأة على زوجها في كلا الحالتين([785]).
أوّلاً: إنّ نفس المستشكل قد احتمل أنّ عبد الله بن سلام قد طلّقها سابقاً في الشام طلقتين تتخلهما رجعتان، وإن كان لا يرى دليلاً على هذا، وإلّا أنّه خير دليل عليه نفس هذه الجملة «لكني أردت إحلالها لبعلها»حيث يمكن استفادة هذا الأمر منها إذا حملنا كلمة الإحلال على معناها الاصطلاحي في باب الطلاق.
ثانياً: لا يتعيّن أن يكون المراد من عبارة «أردت إحلالها لبعلها»هو المعنى الاصطلاحي للإحلال في باب الطلاق، بل المراد منها على تقدير صدورها إرجاع أُرينب إلى زوجها الأوّل بواسطة هذه الحيلة.
قيل: وقد روي ـ باختصار ـ ما هو قريب من هذه القصة مع هند بنت سهيل ابن عمرو، وزوجها عبد الله بن عامر بن كريز مع الإمام الحسن×([786]).
ما هو الإشكال فيما لو التزمنا بحدوث واقعتين؛ إحداهما كانت مع الإمام الحسن×، والثانية وقعت مع الإمام الحسين×، فإذا وجهت هذه الإشكالات على قصة هند مع الإمام الحسن× نجيب بنفس الأجوبة التي أجبنا بها على الإشكالات التي أوردت بشأن قصة أُرينب مع الإمام الحسين×.
طريقتنا في هذه الموسوعة، استخراج الروايات المنسوبة إلى الإمام الحسين× دون بحث سندي لكل منها بخصوصه؛ لأنّ هناك طرقاً لإثبات إسناد الخبر الواحد إلى المعصوم، منها:
وهذا الطريق عادة يرد من قبل الأشخاص الذين يتبنون حجية خبر الثقة، ولذا يحاولون إثبات وثاقة الرواة، وفي حالة عدم وثاقة بعضهم يحكمون بعدم حجية تلك الرواية. وبما أنّ جميع الروايات المنسوبة إلى سيّد الشهداء× لا يمكن إثباتها بهذا الطريق لذا نحاول إثباتها من طرق أخرى.
2 ـ إثبات الوثوق بالخبر
وهذا الطريق عادةً يستفيد منه من يقول بحجية الوثوق بالخبر، وإن كان بعض رواة ذلك الخبر غير ثقاة؛ لأنّهم يعتقدون أنّه يمكن حصول الوثوق بحجية الخبر أو عدم حجيته من غير طريق توثيق السند. وتوجد عدّة طرق لإثبات الوثوق بالخبر:
أ) تأييد مضمون الخبر بالشواهد الحديثية
والمراد أنّ مضمون الخبر يرد في روايات أخرى مع اختلاف في الألفاظ. وعلى سبيل المثال أنّ أهل السنّة قد ضعّفوا حديث (أنا مدينة العلم...) لوجود أبي الصلت الهروي في السند، ولكن مضمون الحديث قد ورد في أحاديث أخرى بشأن الإمام علي× من جملتها: «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»حيث جاء هذا الحديث في سنن الترمذي، وقد جاء هذا المضمون في روايات أخرى.
ولهذا الحديث (مدينة العلم) شواهد من حيث المتن نشير إلى بعضها:
1ـ حديث «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»:
وقد روى هذا الحديث جمع كثير من علماء السنّة أمثال:
ـ أبو عيسى الترمذي([787]).
ـ أحمد بن حنبل([788]).
ـ أبو نعيم الإصفهاني([789]).
ـ ابن المغازلي([790]).
ـ سبط بن الجوزي([791]).
ـ أبو عبد الله الگنجي الشافعي([792]).
ـ محبّ الدين الطبري([793]).
ـ صدر الدين الحموي([794]).
ـ ابن حجر المكي([795]).
ـ المتقي الهندي([796]).
ـ عبد الرؤوف المناوي([797]).
و...
2ـ حديث «أَنَا مَدينةُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»:
وقد روى هذا النص جمع من علماء السنّة أمثال:
ـ الخطيب البغدادي([798]).
ـ عبد الرؤوف المناوي([799]).
ـ القندوزي البلخي([800]).
و...
3ـ حديث «أَنَا دَارُ العلمُ وَعَلِيٌّ بَابُهَا»:
والحديث بهذا النص قد رواه جمع من علماء السنّة أمثال:
ـ محبّ الدين الطبري([801]).
ـ الملّا علي القاري([802]).
و...
ويوجد من بين الأحاديث النبوية ما يؤيد حديث (مدينة العلم) من حيث المضمون نشير إلى بعضها:
قال النبي| لفاطمة الزهراء‘:
«زَوَّجْتُكِ خَيْرَ أَهْلِي، أَعْلَمُهُمْ عِلْماً وَأَفْضَلُهُمْ حِلْماً وَأَوَّلُهُمْ سِلْماً»([803]).
وكذا قال بشأن الإمام علي×:
«أَعْلَمُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي عَلِيُّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»([804]).
وقال أيضاً:
«قُسِمَتِ الْحِكَمُ عَشَرَةَ أَجْزَاءٍ، فَأُعْطِيَ عَلِيٌّ تِسْعَةَ أَجْزَاءٍ وَالنَّاسُ جُزْءاً وَاحِداً»([805]).
وقال أيضاً:
«أَعْلَمُ أُمَّتِي بِالسُّنَّةِ وَالْقَضَاءِ بَعْدَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ»([806]).
واصطلاح التأييد المضموني للحديث من طريق الشواهد الحديثية مشتهر عند السنّة.
قال ابن الصلاح:
«مثال للمتابع والشاهد: روينا من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: أنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به) ورواه ابن جريج، عن عمرو، عن عطاء، ولم يذكر فيه الدباغ.
فذكر الحافظ أحمد البيهقي لحديث ابن عيينة متابعاً وشاهداً:
أمّا المتابع: فإنّ أسامة بن زيد تابعه عن عطاء، وروى بإسناده عن أسامة، عن عطاء عن ابن عباس: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (ألا نزعتم جلدها فدبغتموه، فاستمتعتم به).
وأمّا الشاهد: فحديث عبد الرحمن بن وعلة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (أيما إهاب دبغ فقد طهر). والله أعلم»([807]).
وقد روى الترمذي والطبراني بسنديهما عن زيد بن حسن الأنماطي عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنّه قال:
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي»([808]).
وقال الألباني بعد نقل الحديث المتقدم:
«قلت: لكن الحديث صحيح، فإنّ له شاهداً من حديث زيد بن أرقم قال: (قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوماً فينا خطيباً بماء يدعى (خمّاً) بين مكة والمدينة، فحمد الله، وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثمّ قال: أمّا بعد، ألا أيّها الناس، فإنّما أنا بشر، يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أوّلهما كتاب الله، فيه الهدى والنور [من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضلّ]، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به ـ فحثّ على كتاب الله ورغب فيه، ثمّ قال: ـ وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي).
أخرجه مسلم (7 / 122 ـ 123) والطحاوي في (مشكل الآثار) (4 / 368) وأحمد (4 / 366 ـ 367) وابن أبي عاصم في (السنّة) (1550 و 1551) والطبراني (5026) من طريق يزيد بن حيان التميمي عنه.
ثمّ أخرج أحمد (4 / 371) والطبراني (5040) والطحاوي من طريق علي بن ربيعة قال:
(لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عنده، فقلت له: أسمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: إنّي تارك فيكم الثقلين [كتاب الله وعترتي]؟ قال: نعم).
وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.
وله طرق أخرى عند الطبراني (4969 ـ 4971 و 4980 ـ 4982 و 5040) وبعضها عند الحاكم (3 / 109 و 148 و 533). وصحح هو والذهبي بعضها.
وشاهد آخر من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً:
([إنّي أوشك أن أدعى فأجيب و] إنّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنّهما لن يتفرقا حتّى يردا عليّ الحوض).
أخرجه أحمد (3 / 14 و 17 و 26 و 59) وابن أبي عاصم (1553 و 1555) والطبراني (2678 ـ 2679) والديلمي (2 / 1 / 45).
وهو إسناد حسن في الشواهد.
وله شواهد أخرى من حديث أبي هريرة عند الدار قطني (ص 529) والحاكم (1/93) والخطيب في (الفقيه والمتفقه) (56 /1).
وابن عباس عند الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي...»([809]).
ثمّ قال في آخر كلامه:
«بعد تخريج هذا الحديث بزمن بعيد، كتب عليّ أن أهاجر من دمشق إلى عمان، ثمّ أن أسافر منها إلى الإمارات العربية أوائل سنة (1402) هجرية، فلقيت في (قطر) بعض الأساتذة والدكاترة الطيبين، فأهدى إلي أحدهم رسالة له مطبوعة في تضعيف هذا الحديث، فلما قرأتها تبيّن لي أنّه حديث عهد بهذه الصناعة، وذلك من ناحيتين ذكرتهما له:
الأولى: أنّه اقتصر في تخريجه على بعض المصادر المطبوعة المتداولة، ولذلك قصر تقصيراً فاحشاً في تحقيق الكلام عليه، وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة أو حسنة فضلاً عن الشواهد والمتابعات، كما يبدو لكل ناظر يقابل تخريجه بما خرجته هنا.
الثانية: أنّه لم يلتفت إلى أقوال المصححين للحديث من العلماء، ولا إلى قاعدتهم التي ذكروها في (مصطلح الحديث): أنّ الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، فوقع في هذا الخطأ الفادح من تضعيف الحديث الصحيح»([810]).
ويرى الشيخ الطوسي أنّ إحدى علامات صحة الخبر موافقة مضمونه للسنّة القطعية.
قال في مقدّمة كتاب (الاستبصار):
«وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضاً، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب أيضاً العمل به، وهو لاحق بالقسم الأوّل، والقرائن أشياء كثيرة منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه، ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن إمّا لظاهره أو عمومه أو دليل خطابه أو فحواه، فكلّ هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم، ومنها أن تكون مطابقة للسنّة المقطوع بها إمّا صريحاً أو دليلاً أو فحوى أو عموماً، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه، ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة فإنّ جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيّز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به»([811]).
المراد من المتابعات السندية، الإسناد الأخرى التي وردت للخبر بحيث يمكنها أن تقوي السند وتؤيده، وهذا الاصطلاح أيضاً مشهور عند العامة، وهذا التأييد في الحقيقة يمكن أن ينجر إلى إثبات حجية الخبر عن طريق وثاقة الراوي.
قال ابن الصلاح في تبيين معنى تأييد الخبر بالمتابعات السندية:
«ذكر أبو حاتم محمّد بن حبان التميمي الحافظ (ره) أنّ طريق الاعتبار في الأخبار مثاله: أن يروي حماد بن سلمة حديثاً لم يتابع عليه، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
فينظر: هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ فإن وجد علم أنّ للخبر أصلاً يرجع إليه، وإن لم يوجد ذلك فثقة غير ابن سيرين رواه عن أبي هريرة، وإلّا فصحابي غير أبي هريرة رواه عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، فأيّ ذلك وجد يعلم به أنّ للحديث أصلاً يرجع إليه، وإلّا فلا.
قلت: فمثال المتابعة أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد، فهذه المتابعة التامة، فإن لم يروه أحد غيره عن أيوب لكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فذلك قد يطلق عليه اسم المتابعة أيضاً...»([812]).
ج) التأييد عن طريق متانة النص وعلو مضامينه
إنّ أحد طرق إثبات الخبر والذي يتمّ استخدامه بشكل عام عند علماء الشيعة ومحدثيهم هو متانة مضامين الحديث وبلاغته، بمعنى حصول الوثوق بأنّ هذا النص لا يصدر إلّا عن المعصوم× باعتبار أنّه كلام فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق، ومن هذا القبيل كتاب نهج البلاغة.
قال ابن أبي الحديد:
«... وإنّما ذكرت هذا؛ لأنّ كثيراً من أرباب الهوى يقولون: إنّ كثيراً من «نهج البلاغة» كلام محدث، صنعه قوم من فصحاء الشيعة، وربما عزوا بعضه إلى الرضي أبي الحسن وغيره، وهؤلاء قوم أعمت العصبية أعينهم، فضلوا عن النهج الواضح وركبوا بنيات الطريق، ضلالاً وقلة معرفة بأساليب الكلام، وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط فأقول: لا يخلو إمّا أن يكون كل «نهج البلاغة» مصنوعاً منحولاً، أو بعضه، والأوّل باطل بالضرورة؛ لأنّا نعلم بالتواتر صحة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين×، وقد نقل المحدثون كلهم أو جلهم، والمؤرخون كثيراً منه، وليسوا من الشيعة لينسبوا إلى غرض في ذلك. والثاني يدل على ما قلناه؛ لأنّ من قد أنس بالكلام والخطابة، وشدا طرفاً من علم البيان، وصار له ذوق في هذا الباب لا بدّ أن يفرق بين الكلام الركيك والفصيح، وبين الفصيح والأفصح، وبين الأصيل والمولد، وإذا وقف على كراس واحد يتضمن كلاماً لجماعة من الخطباء، أو لاثنين منهم فقط، فلا بدّ أن يفرّق بين الكلامين، ويميز بين الطريقتين. ألا ترى أنّا مع معرفتنا بالشعر ونقده، لو تصفّحنا ديوان أبي تمام فوجدناه قد كتب في أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره، لعرفنا بالذوق مباينتها لشعر أبي تمام ونفسه، وطريقته ومذهبه في القريض، ألا ترى أنّ العلماء بهذا الشأن حذفوا من شعره قصائد كثيرة منحولة إليه؛ لمباينتها لمذهبه في الشعر، وكذلك حذفوا من شعر أبي نواس شيئاً كثيراً؛ لما ظهر لهم أنّه ليس من ألفاظه، ولا من شعره، وكذلك غيرهما من الشعراء، ولم يعتمدوا في ذلك إلّا على الذوق خاصة.
وأنت إذا تأملت «نهج البلاغة» وجدته كله ماء واحداً، ونفساً واحداً، وأسلوباً واحداً، كالجسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض في الماهية، وكالقرآن العزيز، أوّله كأوسطه، وأوسطه كآخره، وكل سورة منه، وكل آية مماثلة في المأخذ والمذهب والفن والطريق والنظم لباقي الآيات والسور. ولو كان بعض «نهج البلاغة» منحولاً وبعضه صحيحاً، لم يكن ذلك كذلك، فقد ظهر لك بهذا البرهان الواضح ضلال من زعم أنّ هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير المؤمنين×.
واعلم أنّ قائل هذا القول يطرق على نفسه ما لا قبل له به، لأنّا متى فتحنا هذا الباب، وسلطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو، لم نثق بصحة كلام منقول عن رسول الله| أبداً، وساغ لطاعن أن يطعن ويقول هذا الخبر منحول، وهذا الكلام مصنوع...»([813]).
وقال سليمان الكتّاني، الباحث المسيحي بشأن (نهج البلاغة):
«قالوا: إنّ اليد التي امتدت إلى (نهج البلاغة) هي يد طويلة كانت أطول من ثلاثة قرون، ولقد امتدت تتلاعب بالحروف، تصوغها كما يشاء فن الإقحام.
فإذا كان الأمر كذلك، فإنّ للمقحم أطول باع في مجال الفن، إذ طالب غوصاً يؤهله لأن يندمج فيه تمام الاندماج، وكان بارعاً في فن الإخراج، وفن الأداء، وفن التقليد، وفن التمثيل...
وهل الكتاب كان غير تقويم للرجل الكبير في نهجه الطويل، الذي زرع عليه الإنسان قيمة تتبلور بالعقل الصحيح تسمو بالفضيلة، وجعل الفضائل تنمو وتدور على محور واحد هو محور التقوى والإيمان بالله؟
ومتى وفي أيّة لحظة من لحظات عمره لم يعبّر عن هذا النهج الصريح؟
أفي إعلانه الرسالة وإيمانه بها، ولقد نذر نفسه للدعوة لها والجهاد في سبيلها، أم في تطبيقها دستوراً كاملاً لكلّ مجاري أفكاره وأقواله وأعماله من حيث كان زهده وتقواه وشجاعته وبطولته؟...
و(نهج البلاغة)، سواء أكان صقل حروفه على يد ابن أبي طالب أم كان على يد مقحم فنّان، فإنّه يبقى دائماً تعبيراً عميق البلاغة عن نفسيّة رجل واحد سُمّي بـ(علي بن أبي طالب)»([814]).
وأمّا الأحاديث المنسوبة إلى الإمام الحسين× فإنّنا وإن لم نتمكن من إثبات صحة إسنادها، إلّا أنّه يمكن إثباتها من خلال مضامين الروايات الأخرى المؤيّدة لها أو من خلال رصانة المضمون وبلاغته وفصاحته، بحيث لا يصدر هذا الكلام إلّا عن المعصوم×، وعن طريق ذلك يحصل الاطمئنان بصدور الخبر عن المعصوم×.
للعقل مكانة ومنزلة رفيعة في الإسلام، والمراد من العقل هو الأحكام التي يتفق عليها جميع العقلاء مع قطع النظر عمّا فيه النزاع والتعصب، وهي من قبيل حكم العقل بأنّ كلّ ظاهرة لا بدّ لها من علة وأنّ الدور والتسلسل باطل والعدل وحسن والظلم قبيح، إذ إنّ هذه الأحكام العقلية تدور عليها رحى العقيدة والشريعة، ومن أنكر هذه الأحكام لا يستطيع حتّى إثبات وجود الله تعالى.
قال الله تعالى:
(فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ)([815]).
وقد ورد في القرآن الكريم الحثّ على التعقل والتفكر. ومن هنا يستفاد أنّ منطق العقل هو الحجية القطعية بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده؛ ولهذا من الممكن أن يمثل المعيار الآخر للتمييز بين الحق والباطل.
وكما أشرنا سابقاً إلى أنّ الشيخ الطوسي في كتاب (الاستبصار) عدّ موافقة مضمون الخبر للأدلة العقلية من جملة علامات صحته.
القرآن الكريم هو المصدر الأوّل والمرجع الأوّل للمسلمين في مجال العقيدة والأحكام، والقرآن الكريم يعرّف نفسه بقوله:
(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) ([816]).
ومن هذه الناحية فإنّ القرآن هو الميزان بين الحق والباطل في المسائل العقائدية والأحكام الشرعية التي تصلنا عن طريق الروايات، وهذا يحتم علينا مقارنة الحديث بالقرآن الكريم.
وقد روى الفخر الرازي عن النبي|:
«إذَا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ وَإِلّا فَرُدُّوهُ»([817]).
وقال أيوب بن الحرّ سمعت الإمام الصادق× يقول:
«كُلُّ شَيْءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَكُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللهِ فَهُوَ زُخْرُفٌ»([818]).
المراد من عرض الحديث على القرآن إحراز عدم مخالفة الحديث للقرآن الكريم، لا أنّه يجب أن تكون هناك آية من القرآن الكريم موافقة لمضمون الحديث.
على سبيل المثال قد روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنّه روى عن النبي|:
«الميِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ»([819]).
مفاد هذه الرواية لا يتناسب مع القرآن الكريم؛ لأنّ الله تعالى يقول:
(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) ([820]).
وقد أشار الشيخ الطوسي في كتاب (الاستبصار) إلى أنّ أحد علامات صحّة نص ومضمون الحديث موافقته للقرآن الكريم.
إذا اتفقت الأمة على أمرٍ ما فهو دليل قطعي على صدقه وهذا طريق قد اتفقت الشيعة والعامّة عليه، وإن كان الشيعة يرون أنّ حجّية الإجماع ناشئة من كشفه عن رأي المعصوم×، وبناء على هذا الأساس إذا كان الحديث مخالفاً لاتفاق الأمة فيسقط عن الاعتبار ويحكم عليه بأنّه موضوع ومختلق.
وعلى سبيل المثال روى الطحاوي بسنده عن أنس أنّه قال:
«مَطَرَتِ السَّمَاءُ بَرَداً، فَقَالَ لَنَا أَبُو طَلْحَةَ: نَاوِلُونِي مِنْ هَذَا الْبَرَدِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَقُلْتُ: أَتَأْكُلُ الْبَرَدَ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ بَرَدٌ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نُطَهِّرُ بِهِ بُطُونَنَا، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا بِشَرَابٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ: (خُذْهَا عَنْ عَمِّكَ)»([821]).
والحال أنّ مضمون الرواية مخالف لإجماع الأمة واتفاقها على أنّ مطلق الأكل والشرب مبطل للصيام، ومن هنا فيمكن الحكم على هذا الحديث بأنّه موضوع ومختلق.
وكما سبقت الإشارة إلى أنّ الشيخ الطوسي في كتاب (الاستبصار) قد عدَّ أحد علامات صحة النص ومضمون الحديث هو موافقته للإجماع.
وإن كنّا في البحث الماضي بصدد إثبات الحجيّة لكثير من الأحاديث التي يعتقد البعض بناءً على مبناهم في الحجيّة أنّها خارجة عن دائرة الأخبار المعتبرة، حيث أثبتنا حجّيتها وأدخلناها في نطاق الأخبار المعتبرة، ولكن لا ينبغي الخروج من حالة التفريط والوقوع في حالة الإفراط، والاعتقاد بصحّة جميع الأخبار المنسوبة إلى الأئمة المعصومين^ ونرفع اليد عن دراسة الأحاديث.
يظنّ بعض علماء السنّة أنّ الشيعة يعتقدون بحجّية واعتبار جميع الروايات التي جاءت في المصادر الحديثية، ونتيجةً لهذا الظن حاولوا إيراد الإشكالات على بعض الروايات التي تحتوي على مشاكل من حيث النص والمضمون المنقولة في المصادر الشيعية، في حين أنّ علماء الشيعة ليس لديهم هكذا اعتقاد تجاه كتبهم الحديثية، بل ولا يعتقدون بذلك حتّى بالنسبة إلى الكتب الأربعة فضلاً عن الكتب التي هي أقلّ منها بمرتبتين والتي لم يدع أحد من العلماء أنّ جميع رواياتها صحيحة السند وأنّها مطابقة للواقع.
واللطيف أنّ نفس مؤلفي هذه الكتب لم يدّعوا هذا الادّعاء، فعلى سبيل المثال: إنّ العلامة المجلسي قال بشأن الأحاديث التي جمعها في كتابه (بحار الأنوار):
«اعلم أنّ الغلو في النبي والأئمة^ إنّما يكون بالقول بألوهيتهم أو بكونهم شركاء لله تعالى في المعبودية أو في الخلق والرزق، أو أنّ الله تعالى حلّ فيهم أو اتحد بهم، أو أنّهم يعلمون الغيب بغير وحي أو إلهام من الله تعالى، أو بالقول في الأئمة^ إنّهم كانوا أنبياء، أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعض، أو القول بأنّ معرفتهم تغني عن جميع الطاعات ولا تكليف معها بترك المعاصي.
والقول بكل منها إلحاد وكفر وخروج عن الدين كما دلت عليه الأدلة العقلية والآيات والأخبار السالفة وغيرها، وقد عرفت أنّ الأئمة^ تبرؤوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا بقتلهم، وإن قرع سمعك شيء من الأخبار الموهمة لشيء من ذلك فهي إمّا مؤولة أو هي من مفتريات الغلاة»([822]).
مع هذا الشرح والتوضيح كيف يصح إيراد الإشكالات والتهجم على علماء الشيعة لوجود روايات فيها غلو أو روايات تخالف العقل أو القرآن أو السنّة المتواترة.
إنّما يرد هذا الإشكال على علماء السنّة، حيث إنّهم أطلقوا اسم الصحاح على كتبهم الحديثية الستّة، وخاصةً الكتابين الذين يرون أنّهما بلغا درجةً في الصحة أن أصبحا بعد القرآن الكريم فعبّروا عنهما بالصحيحين، وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم، في حين أنّه توجد هكذا أحاديث فيهما وبالرغم من ذلك ما زال هذا الاعتقاد قائماً بالنسبة إليهما؟!
* القرآن الكريم.
* نهج البلاغة، قم ـ إيران، مؤسسة دار الهجرة، 1414ﻫ.ق.
1. ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة، دار إحياء الكتب العربية، 1385 ﻫ.ق.
2. ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمّد، المصنّف في الأحاديث والآثار، بيروت ـ لبنان، دار التاج، 1409 ﻫ.ق.
3. ابن إدريس، محمّد بن أحمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم ـ إيران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1410 ﻫ.ق.
4. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح، بيروت ـ لبنان، دار الأضواء، 1411 ﻫ.ق.
5. ابن الأثير، المبارك بن محمّد، النهاية في غريب الحديث والأثر، قم ـ إيران، مؤسسة إسماعيليان، 1367 ﻫ.ش.
6. ابن الأثير، علي بن محمّد بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ، بيروت ـ لبنان، دار الكتاب العربي، 1417 ﻫ.ق.
7. ابن الأثير، علي بن محمّد، أسد الغابة في معرفة الصحابة، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1409 ﻫ.ق.
8. ابن الجوزي، يوسف بن قزأوغلي، تذكرة الخواص، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1418 ﻫ.ق.
9. ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، علوم الحديث، بيروت ـ دمشق، دار الفكر المعاصر ـ دار الفكر، 1406 ﻫ.ق.
10. ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دمشق ـ بيروت، دار ابن كثير، 1406 ﻫ.ق.
11. ابن المغازلي، علي بن محمّد، مناقب أهل البيت^، طهران ـ إيران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، المعاونية الثقافية، مركز التحقيقات والدراسات العلمية، 1427 ﻫ.ق.
12. ابن الهمام، كمال الدين محمّد بن عبد الواحد، فتح القدير، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، بلا تاريخ.
13. ابن بابويه الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي، طهران ـ إيران، مؤسسة البعثة، 1435 ﻫ.ق.
14. ابن بابويه الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1406 ﻫ.ق.
15. ابن بابويه الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع، قم ـ إيران، مكتبة الداوري، 1385 ﻫ.ق.
16. ابن بابويه الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا×، طهران ـ إيران، جهان، 1378 ﻫ.ق.
17. ابن بابويه الصدوق، محمّد بن علي، كمال الدين وتمام النعمة، طهران ـ إيران، دار الكتب الإسلامية، 1395 ﻫ.ق.
18. ابن بابويه الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، قم ـ إيران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1413 ﻫ.ق.
19. ابن بدرون، عبد الملك بن عبد الله، شرح قصيدة ابن عبدون، القاهرة ـ مصر، محيي الدين صبري الكردي، 1340 ﻫ.ق.
20. ابن بسطام، عبد الله وحسين، طب الأئمة^، النجف الأشرف ـ العراق، المطبعة الحيدرية، 1385 ﻫ.ق.
21. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، المدينة ـ السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 1416 ﻫ.ق.
22. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية، الرياض ـ السعودية، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، 1406 ﻫ.ق.
23. ابن حبان، محمّد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة، 1414 ﻫ.ق.
24. ابن حجة، تقي الدين بن علي، ثمرات الأوراق، بيروت ـ لبنان، المكتبة العصرية، 1426 ﻫ.ق.
25. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1415 ﻫ.ق.
26. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب، الهند، مطبعة دائرة المعارف النظامية، 1326 ﻫ.ق.
27. ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمّد، الصواعق المحرقة، لبنان، مؤسسة الرسالة، 1417 ﻫ.ق.
28. ابن حنبل، أحمد بن محمّد، فضائل الصحابة، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة، 1403 ﻫ.ق.
29. ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة، 1421 ﻫ.ق.
30. ابن سعد، محمّد بن سعد، الطبقات الكبرى، الطبقة الخامسة من الصحابة، الطائف ـ السعودية، مكتبة الصديق، بلا تاريخ.
31. ابن سعد، محمّد بن سعد، الطبقات الكبرى، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1410 ﻫ.ق.
32. ابن شعبة، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول (صلى الله عليهم)، قم ـ إيران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1404 ﻫ.ق.
33. ابن شهر آشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب^، قم ـ إيران، العلّامة، 1379 ﻫ.ق.
34. ابن صباغ، علي بن محمّد، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، قم ـ إيران، دار الحديث للطباعة والنشر، 1422 ﻫ.ق.
35. ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال، طهران ـ إيران، دار الكتب الإسلامية، 1409 ﻫ.ق.
36. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1414 ﻫ.ق.
37. ابن طاووس، علي بن موسى، جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1330 ﻫ.ق.
38. ابن طاووس، علي بن موسى، سعد السعود للنفوس، قم ـ إيران، الدليل، 1421 ﻫ.ق.
39. ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات، قم ـ إيران، دار الذخائر، 1411 ﻫ.ق.
40. ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، بيروت ـ لبنان، دار الجيل، 1412 ﻫ.ق.
41. ابن عبد ربه، أحمد بن محمّد، العقد الفريد، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1404 ﻫ.ق.
42. ابن عجيبة، أحمد، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، القاهرة ـ مصر، دار جوامع الكلم، 2005 م.
43. ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1415 ﻫ.ق.
44. ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم ـ إيران، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 ﻫ.ق.
45. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة، بيروت ـ لبنان، دار الأضواء، 1410 ﻫ.ق.
46. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، المعارف، القاهرة ـ مصر، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، 1992 م.
47. ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، عيون الأخبار، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1418 ﻫ.ق.
48. ابن قيم الجوزية، محمّد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، ، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1411 ﻫ.ق.
49.
ابن قيم الجوزية، محمّد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي
خير العباد، بيروت ـ
لبنان، مؤسسة الرسالة، 1418 ﻫ.ق.
50. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1407 ﻫ.ق.
51. ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1419 ﻫ.ق.
52. ابن ماجة، محمّد بن يزيد، سنن ابن ماجة، القاهرة ـ مصر، دار إحياء الكتب العربية، بلا تاريخ.
53. ابن نما، جعفر بن محمّد، مثير الأحزان، قم ـ إيران، مدرسة الإمام المهدي×، 1406 ﻫ.ق.
54. ابن يوسف، أبو حيان محمّد، البحر المحيط في التفسير، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1420 ﻫ.ق.
55. أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1416 ﻫ.ق.
56. أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى، دمشق ـ سورية، دار المأمون للتراث، 1404 ﻫ.ق.
57. أبي بكر البوصيري، أحمد بن أبي بكر، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، بيروت ـ لبنان، دار العربية، 1403 ﻫ.ق.
58. الآبي، منصور بن الحسين، نثر الدر في المحاضرات، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1424 ﻫ.ق.
59. أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×، قم ـ إيران، أنوار الهدى، 1423 ﻫ.ق.
60. الإربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمة، تبريز ـ إيران، بني هاشمي، 1381 ﻫ.ق.
61. أفشار، إيرج، دانش پژوه، محمّد تقي، فهرست كتابهاي خطي كتابخانه ملي ملك وابسته به آستان قدس رضوي (فهرس الكتب الخطية لمكتبة ملك الوطنية التابعة للعتبة الرضوية المقدّسة)، طهران ـ إيران، مكتبة ملك الوطنية، 1352 ﻫ.ش.
62. الأفندي، عبد الله بن عيسى بيك، رياض العلماء وحياض الفضلاء، بيروت ـ لبنان، مؤسسة التاريخ العربي، 1431 ﻫ.ق.
63. آقا بزرگ الطهراني، محمّد محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بيروت ـ لبنان، دار الأضواء، 1403 ﻫ.ق.
64. آقا بزرگ الطهراني، محمّد محسن، طبقات أعلام الشيعة، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1430 ﻫ.ق.
65. الألباني، محمّد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، الرياض ـ السعودية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 1415 ﻫ.ق.
66. الألباني، محمّد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته، المكتب الإسلامي، بلا تاريخ.
67. الألباني، محمّد ناصر الدين، صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، الرياض ـ السعودية، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1422 ﻫ.ق.
68. الآلوسي، محمود بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1415 ﻫ.ق.
69. الإمام السجاد، علي بن الحسين×، الصحيفة السجادية، قم ـ إيران، نشر الهادي، 1376 ﻫ.ش.
70. الآمدي، عبد الواحد بن محمّد، غرر الحكم ودرر الكلم، قم ـ إيران، دار الكتاب الإسلامي، 1410 ﻫ.ق.
71. الآملي، حسن حسن زادة، رساله نور على نور در ذكر وذاكر ومذكور (رسالة نور على نور في الذكر والذاكر والمذكور)، قم ـ إيران، تشيع، 1371 ﻫ.ش.
72. الأمين، محسن، أعيان الشيعة، بيروت ـ لبنان، دار التعارف للمطبوعات، 1403 ﻫ.ق.
73. أنوار، عبد الله، فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران (فهرس النسخ الخطية لمكتبة إيران الوطنية)، طهران ـ إيران، مكتبة إيران الوطنية، 1356 ﻫ.ش.
74. البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري، بيروت ـ لبنان، دار طوق النجاة، 1422 ﻫ.ق.
75. البزار، أحمد بن عمرو، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، المدينة ـ السعودية، مكتبة العلوم والحكم، 1988 م.
76.
البغوي، حسين بن مسعود، تفسير البغوي المسمّى معالم
التنزيل، بيروت ـ
لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1420 ﻫ.ق.
77. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1417 ﻫ.ق.
78. بهجت، محمّد تقي، مناسك حج وعمره، قم ـ إيران، مكتب آية الله العظمى بهجت، 1424 ﻫ.ق.
79. البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1418 ﻫ.ق.
80. البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1424 ﻫ.ق.
81. ترابي، حسين، پژوهشي درباره ذيل دعاي عرفه (بحث حول ذيل دعاء عرفة)، ميقات حج، رقم: 51، صفحة 44 ـ 70، 1384 ﻫ.ش.
82. الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي، القاهرة ـ مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395 ﻫ.ق.
83. الثعلبي، أحمد بن محمّد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1422 ﻫ.ق.
84. الجوهري البصري، أحمد بن عبد العزيز، السقيفة وفدك، طهران ـ إيران، مكتبة نينوى الحديثة، بلا تاريخ.
85. الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، بيروت ـ لبنان، دار العلم للملايين، 1376 ﻫ.ق.
86. حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، بلا تاريخ.
87. الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1411 ﻫ.ق.
88. الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس، قم ـ إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1418 ﻫ.ق.
89. الحائري، عبد الحسين، فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملي (فهرس مكتبة مجلس الشورى الوطني)، طهران ـ إيران، مجلس الشورى الوطني، 1352 ﻫ.ش.
90. حجتي، محمّد باقر، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دانشكده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه تهران (فهرس النسخ الخطية لمكتبة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية في جامعة طهران)، طهران ـ إيران، جامعة طهران، 1348 ﻫ.ش.
91. الحر العاملي، محمّد بن الحسن، أمل الآمل في علماء جبل عامل، بغداد ـ عراق، مكتبة الأندلس، بلا تاريخ.
92. الحر العاملي، محمّد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1409 ﻫ.ق.
93.
الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله، شواهد التنزيل
لقواعد التفضيل، طهران ـ
إيران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مكتب الطباعة والنشر، 1411 ﻫ.ق.
94. الحسيني الإشكوري، أحمد، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آيت الله العظمى نجفي مرعشي (فهرس النسخ الخطية لمكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي العامة)، قم ـ إيران، مكتبة آية الله المرعشي، بلا تاريخ.
95. الحسيني الإشكوري، أحمد، فهرست نسخه هاي خطي مركز احياء ميراث اسلامي (فهرس النسخ الخطية لمركز إحياء التراث الإسلامي)، قم ـ إيران، مجمع الذخائر الإسلامي، 1383 ﻫ.ش.
96. الحسيني الإشكوري، جعفر، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مدرسه جعفريه: زهان ـ ايران (فهرس النسخ الخطية لمكتبة المدرسة الجعفرية: زهان ـ إيران)، قمـإيران، مجمع الذخائر الإسلامي، 1383 ﻫ.ش.
97. الحسيني الحائري، كاظم، مناسك الحج، قم ـ إيران، دار البشير، 1427 ﻫ.ق.
98. الحسيني، جواد، «نيم نگاهي به شرح فرازهايي از دعاي عرفه» (نظرة مقتضبة إلى شرح مقاطع من دعاء عرفة) ميقات حج، رقم: 42، 1381 ﻫ.ش.
99. حسينيان القمي، مهدي، دفاع از بخش پاياني دعاي عرفه امام حسين× (الدفاع عن القسم الأخير من دعاء الإمام الحسين× في عرفة)، سمات، رقم: 5، صفحة 56 ـ 69، 1390 ﻫ.ش.
100. الحلواني، الحسين بن محمّد، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، قم ـ إيران، مدرسة الإمام المهدي×، 1408 ﻫ.ق.
101. الحموي الجويني، إبراهيم بن محمّد، فرائد السمطين، بيروت ـ لبنان، مؤسسة المحمودي، 1400 ﻫ.ق.
102. الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1413 ﻫ.ق.
103. الخامنئي، علي، مناسك الحج، طهران ـ إيران، مشعر، 1426 ﻫ.ق.
104. خاني، حامد، دفاع از اصالت ادعيه اهل بيت^: مطالعه موردي دعاي عرفه (الدفاع عن أصالة أدعية أهل البيت^: دراسة حول دعاء عرفة)، حديث پژوهي، رقم: 10، صفحة 57 ـ 94، 1392 ﻫ.ش.
105. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، المتفق والمفترق، دمشق ـ سورية، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، 1417 ﻫ.ق.
106. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1417 ﻫ.ق.
107. الخميني، روح الله الموسوي، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، طهران ـ إيران، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، 1376 ﻫ.ش.
108. الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطني، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة، 1424 ﻫ.ق.
109. الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي، الرياض ـ السعودية، دار المغني للنشر والتوزيع، 1421 ﻫ.ق.
110. دانش پژوه، محمّد تقي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران (فهرس النسخ الخطية للمكتبة المركزية في جامعة طهران)، طهران ـ إيران، مؤسسة الطباعة والنشر في جامعة طهران، 1357 ﻫ.ش.
111. درود آبادي الهمداني، حسين بن محمّد تقي، شرح الأسماء الحسنى، قم ـ إيران، بيدار، 1426 ﻫ.ق.
112. الدعوات، سعيد بن هبة الله القطب الراوندي، قم ـ إيران، مدرسة الإمام المهدي×، 1407 ﻫ.ق.
113. الديلمي، شيرويه بن شهردار، الفردوس بمأثور الخطاب، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1406 ﻫ.ق.
114. الذهبي، محمّد بن أحمد، تذكرة الحفاظ، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1419 ﻫ.ق.
115. الذهبي، محمّد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة، 1405 ﻫ.ق.
116. الرازي، علي بن محمّد خزاز، كفاية الأثر في النص على الأئمّة الاثني عشر، قم ـ إيران، بيدار، 1401 ﻫ.ق.
117. الراغب الإصفهاني، حسين بن محمّد، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق ـ بيروت، دار القلم ـ الدار الشامية، 1412 ﻫ.ق.
118. رخشاد، محمّد حسين، در محضر حضرت آيت الله العظمى بهجت (بين يدي آية الله العظمى بهجت)، قم ـ إيران، مؤسسة سماء الثقافية، 1389 ﻫ.ش.
119. روملو، حسن، أحسن التواريخ، طهران ـ إيران، أساطير، 1384 ﻫ.ش.
120. الريشهري، محمّد، الطباطبائي نژاد، محمود، السيّد طبائي، روح الله، موسوعة الإمام الحسين× في الكتاب والسنة والتاريخ، قم ـ إيران، دار الحديث للطباعة والنشر، 1431 ﻫ.ق.
121. الزبيري، الزبير بن بكار، الأخبار الموفقيات، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1416 ﻫ.ق.
122. الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت ـ لبنان، دار الكتاب العربي، 1407 ﻫ.ق.
123. الزمخشري، محمود بن عمر، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1412 ﻫ.ق.
124. السبحاني التبريزي، جعفر، مناسك الحج وأحكام العمرة، قم ـ إيران، مؤسسة الامام الصادق×، 1428 ﻫ.ق.
125. السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، صيدا ـ بيروت، المكتبة العصرية، بلا تاريخ.
126. سعادت پرور، علي، پاسداران حريم عشق (حماة حدود المحبة)، طهران ـ إيران، إحياء الكتاب، 1388 ﻫ.ش.
127. سعادت پرور، علي، نور هدايت (نور الهداية)، طهران ـ إيران، إحياء الكتاب، 1386 ﻫ.ش.
128. السقاف، حسن بن علي، صحيح شرح العقيدة الطحاوية، بيروت ـ لبنان، دار الإمام الرواس، 1428 ﻫ.ق.
129. السيستاني، علي، مناسك الحج، قم ـ إيران، مكتب آية الله العظمى السيستاني، بلا تاريخ.
130. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، بلا تاريخ.
131. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جامع الأحاديث، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1414 ﻫ.ق.
132. الشامي، يوسف بن حاتم، الدر النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم، قم ـ إيران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1420 ﻫ.ق.
133. الشبراوي، عبد الله بن محمّد، الإتحاف بحبّ الأشراف، قم ـ إيران، دار الكتاب الإسلامي، 1423 ﻫ.ق.
134. الشبلنجي، مؤمن، نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار|، قم ـ إيران، الشريف الرضي، بلا تاريخ.
135. الشبيري الزنجاني، موسى، جرعه اي از دريا (رشفة من بحر)، قم ـ إيران، مؤسسة كتاب شناسي شيعة، 1393 ﻫ.ش.
136. الشبيري الزنجاني، موسى، مناسك الحج، قم ـ إيران، مشرقين، 1421 ﻫ.ق.
137. الشرتوني، سعيد، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، قم ـ إيران، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1403 ﻫ.ق.
138. الشرقاوي، عبد الله، شرح حكم ابن عطاء الله السكندري، القاهرة ـ مصر، مكتبة الثقافة الدينية، 1425 ﻫ.ق.
139. الشعراني، أبو الحسن، دعاي عرفه حضرت ابا عبد الله الحسين× (دعاء عرفة لأبي عبد الله الحسين×)، قم ـ إيران، روح، 1383 ﻫ.ش.
140. الشهرستاني، محمّد بن عبد الكريم، الملل والنحل، بيروت ـ لبنان، دار المعرفة، 1415 ﻫ.ق.
141. الشهيد الأوّل، محمّد بن مكي، الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة، ترجمة عبد الهادي المسعودي، قم ـ إيران، الحضرة المقدّسة في قم، نشر الزائر، 1379 ﻫ.ش.
142. الشوكاني، محمّد بن علي، نيل الأوطار، مصر، دار الحديث، 1413 ﻫ.ق.
143. الصدرائي الخوئي، علي، بخش دوم دعاى عرفه هم جزو دعا ومنتسب به سيد الشهداء× است (القسم الثاني من دعاء عرفة جزء من الدعاء ولسيّد الشهداء×)، مرداد 1392 ﻫ.ش.
144. الصدرائي الخوئي، علي، ذيل دعاي عرفه (ذيل دعاء عرفة)، اسفند 1385 ﻫ.ش.
http://sadraiy.blogfa.com/post-73.aspx.http://shafaqna.com/persian/services/dialogue/item/54589.
145. الصدرائي الخوئي، علي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي (فهرس النسخ الخطية لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي)، قم ـ إيران، مركز نشر مكتب الإرشاد الإسلامي التابع للحوزة العلمية في قم، 1376 ﻫ.ش.
146. الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد^، قم ـ إيران، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1404 ﻫ.ق.
147. الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390 ﻫ.ق.
148. الطباطبائي، محمّد حسين، رسالة الولاية، قم ـ إيران، مؤسسة أهل البيت^، قسم الدراسات الإسلامية، 1360 ﻫ.ش.
149. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، القاهرة ـ مصر، دار الحرمين، بلا تاريخ.
150. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الصغير، بيروت ـ عمان، المكتب الإسلامي ـ دار عمار، 1405 ﻫ.ق.
151. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، القاهرة ـ مصر، مكتبة ابن تيمية، بلا تاريخ.
152. الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج، مشهد المقدّسة ـ إيران، نشر المرتضى، 1403 ﻫ.ق.
153. الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق، قم ـ إيران، الشريف الرضي، 1412 ﻫ.ق.
154. الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى، قم ـ إيران، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1417 ﻫ.ق.
155. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، طهران ـ إيران، ناصر خسرو، 1372 ﻫ.ش.
156. الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، بيروت ـ لبنان، دار التراث، 1387 ﻫ.ق.
157. الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت ـ لبنان، دار المعرفة، 1412 ﻫ.ق.
158. الطحاو، أحمد بن محمّد، شرح مشكل الآثار، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة، 1415 ﻫ.ق.
159. الطهراني الحسيني، محمّد حسين، معرفة الله، ترجمة عباس جواد الصافي، بيروت ـ لبنان، دار المحجة البيضاء، 1420 ﻫ.ق.
160. الطهراني الحسيني، محمّد حسين، معرفة المعاد، ترجمة عبد الرحيم مبارك، بيروت ـ لبنان، دار المحجة البيضاء، 1416 ﻫ.ق.
161. الطهراني الحسيني، محمّد حسين، نور ملكوت القرآن، ترجمة حسن إبراهيم، بيروت ـ لبنان، دار المحجة البيضاء، 1421 ﻫ.ق.
162. الطوسي، محمّد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، طهران ـ إيران، دار الكتب الإسلامية، 1390 ﻫ.ق.
163. الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي، قم ـ إيران، دار الثقافة، 1414 ﻫ.ق.
164. الطوسي، محمّد بن الحسن، الخلاف، قم ـ إيران، جامعة المدرسين في الحوزة العلمية قم، مكتب النشر الإسلامي، 1407 ﻫ.ق.
165. الطوسي، محمّد بن الحسن، الغيبة، قم ـ إيران، مؤسسة المعارف الإسلامية، 1411 ﻫ.ق.
166. الطوسي، محمّد بن الحسن، تهذيب الأحكام، طهران ـ إيران، دار الكتب الإسلامية، 1407 ﻫ.ق.
167. الطوسي، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجد، بيروت ـ لبنان، مؤسسة فقه الشيعة، 1411 ﻫ.ق.
168. عرب زادة، أبو الفضل، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمى گلپايگانى (فهرس النسخ الخطية لمكتبة آية الله العظمى الگلپايگاني العامّة)، قم ـ إيران، دار القرآن الكريم، 1378 ﻫ.ش.
169. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق، بيروت ـ لبنان، دار الكتاب اللبناني، 1982 م.
170. العياشي، محمّد بن مسعود، تفسير العياشي، طهران ـ إيران، المكتبة العلمية الإسلامية، 1380 ﻫ.ق.
171. الفاضل، محمود، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جامع گوهرشاد مشهد (فهرس النسخ الخطية لمكتبة جامع گوهرشاد في مشهد)، مشهد المقدّسة ـ إيران، مكتبة جامع گوهرشاد، 1363 ﻫ.ش.
172. الفتال النيسابوري، محمّد بن الحسن، روضة الواعظين، قم ـ إيران، الشريف الرضي، بلا تاريخ.
173. الفخر الرازي، محمّد بن عمر، التفسير الكبير، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1420 ﻫ.ق.
174. الفياض، محمّد إسحاق، مناسك الحج، قم ـ إيران، عزيزي، 1418 ﻫ.ق.
175. الفيض الكاشاني، محمّد بن شاه مرتضى، الحقائق في محاسن الأخلاق؛ قرّة العيون في المعارف والحكم، قم ـ إيران، دار الكتاب الإسلامي، 1423 ﻫ.ق.
176. الفيض الكاشاني، محمّد بن شاه مرتضى، الوافي، إصفهان ـ إيران، مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي× العامّة، 1406 ﻫ.ق.
177. الفيومي، أحمد بن محمّد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، قم ـ إيران، مؤسسة دار الهجرة، 1414 ﻫ.ق.
178. القاري، علي بن سلطان محمّد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، 1422 ﻫ.ق.
179. القاضي سعيد القمي، محمّد سعيد بن محمّد مفيد، شرح توحيد الصدوق، طهران ـ إيران، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مكتب الطباعة والنشر، 1415 ﻫ.ق.
180. القرطبي، محمّد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة ـ مصر، دار الكتب المصرية، 1384 ﻫ.ق.
181. القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، القاهرة ـ مصر، دار إحياء الكتب العربية، بلا تاريخ.
182. القمي، عباس، كليات مفاتيح الجنان، قم ـ إيران، أسوة، بلا تاريخ.
183. القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى، قم ـ إيران، منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، دار الأسوة للطباعة والنشر، 1422 ﻫ.ق.
184. الكتاني، سليمان، الإمام علي×؛ نبراس ومتراس، النجف الأشرف ـ العراق، العتبة العلوية المقدّسة ـ قسم الشؤون الفكرية والثقافية، 1432 ﻫ.ق.
185. الكرباسجي، محمّد مهدي، بررسي متن، سند، شروح ونسخ خطي مصادر اوليه قسمت دوم دعاى عرفه سيد الشهداء× (دراسة في إسناد القسم الثاني من دعاء عرفة لسيّد الشهداء× ونصّه وشروحه ومخطوطات مصادره الأولى)، رسالة ماجستير في فرع علوم الحديث، كلية علوم الحديث، طهران، 1385 ﻫ.ش.
186. الكرباسي، محمّد صادق محمّد، الصحيفة الحسينية الكاملة، لندن ـ إنجلترا، المركز الحسيني للدراسات، 1428 ﻫ.ق.
187. الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين، طهران ـ إيران، مكتبة الصدوق، بلا تاريخ.
188. الكفعمي، إبراهيم بن علي، مصباح الكفعمي، قم ـ إيران، دار الرضي ـ زاهدي، 1405 ﻫ.ق.
189. الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، طهران ـ إيران، دار الكتب الإسلامية، 1407 ﻫ.ق.
190. كولبرغ، إيتان، كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او (مكتبة ابن طاووس وأحواله وآثاره)، ترجمة رسول جعفريان وعلي قرائي، قم ـ إيران، المكتبة العامّة لآية الله العظمى المرعشي النجفي، 1371 ﻫ.ش.
191. الگلپايگاني، لطف الله الصافي، پرتوي از عظمت امام حسين× (أشعة من عظمة الإمام الحسين×)، قم ـ إيران، مكتب تنظيم ونشر آثار آية الله العظمى صافي الگلپايگاني، 1395 ﻫ.ش.
192. الگنجي، محمّد بن يوسف، كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب×، طهران ـ إيران، دار إحياء تراث أهل البيت^، 1404 ﻫ.ق.
193. المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الرسالة، 1401 ﻫ.ق.
194. المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1403 ﻫ.ق.
195. المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، زاد المعاد، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1423 ﻫ.ق.
196. المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، طهران ـ إيران، دار الكتب الإسلامية، 1404 ﻫ.ق.
197. محب الدين الطبري، أحمد بن عبد الله، الرياض النضرة في مناقب العشرة، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1424 ﻫ.ق.
198. محب الدين الطبري، أحمد بن عبد الله، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، القاهرة ـ مصر، مكتبة القدسي، 1356 ﻫ.ق.
199. مخلوف، محمّد بن محمّد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1424 ﻫ.ق.
200. مرتضى العاملي، جعفر، سيرة الحسين في الحديث والتاريخ، بيروت ـ لبنان، المركز الإسلامي للدراسات، 1435 ﻫ.ق.
201. المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، بلا تاريخ.
202. مرواريد، حسنعلي، تنبيهات حول المبدأ والمعاد، مشهد المقدّسة ـ إيران، العتبة الرضوية المقدّسة، مركز البحوث الإسلامية، 1418 ﻫ.ق.
203. المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر، قم ـ إيران، مؤسسة دار الهجرة، 1409 ﻫ.ق.
204. المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، قم ـ إيران، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413 ﻫ.ق.
205. المفيد، محمّد بن محمّد، الفصول المختارة، قم ـ إيران، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1413 ﻫ.ق.
206. مكارم الشيرازي، ناصر، كليات مفاتيح نوين، قم ـ إيران، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب×، 1390 ﻫ.ش.
207. مكارم الشيرازي، ناصر، مناسك جامع حج (المناسك الجامعة للحج)، قم ـ إيران، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب×، 1426 ﻫ.ق.
208. الملكي التبريزي، جواد بن شفيع، رسالة لقاء الله، قم ـ إيران، آل علي×، 1385 ﻫ.ش.
209. المناوي، محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين، فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، 1356 ﻫ.ق.
210. المنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفين، قم ـ إيران، مكتبة آية الله المرعشي النجفي، 1404 ﻫ.ق.
211. النجفي، محمّد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت ـ لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1404 ﻫ.ق.
212. النراقي، مهدي بن أبي ذر، جامع السعادات، بيروت ـ لبنان، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بلا تاريخ.
213. النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي، حلب ـ سورية، مكتب المطبوعات الإسلامية، 1406 ﻫ.ق.
214. النسفي، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بيروت ـ لبنان، دار النفائس، 1416 ﻫ.ق.
215. النصيبي الشافعي، محمّد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، بيروت ـ لبنان، مؤسسة البلاغ، 1419 ﻫ.ق.
216. نظام الأعرج النيسابوري، الحسن بن محمّد، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، بيروت ـ لبنان، دار الكتب العلمية، 1416 ﻫ.ق.
217. النعماني، محمّد بن إبراهيم، الغيبة، طهران ـ إيران، مكتبة الصدوق، 1397 ﻫ.ق.
218. النوري، حسين بن محمّد تقي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، بيروت ـ لبنان، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1408 ﻫ.ق.
219. النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، القاهرة ـ مصر، دار الكتب والوثائق القومية، 1423 ﻫ.ق.
220. همائي، جلال الدين، مولوي نامه؛ مولوي چه مي گويد؟ (الرسالة المولوية؛ مولوي ماذا يقول؟)، طهران ـ إيران، مؤسسة نشر هما، 1385 ﻫ.ش.
221. الهمداني، جواد مقصود، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه غرب مدرسه آخوند ـ همدان (فهرس النسخ الخطية لمكتبة غرب مدرسة آخوند ـ همدان)، همدان ـ إيران، 1356 ﻫ.ش.
222. الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، القاهرة ـ مصر، مكتبة القدسي، 1414 ﻫ.ق.
223. الوحيد الخراساني، حسين، مناسك الحج، قم ـ إيران، مدرسة الإمام باقر العلوم×، 1428 ﻫ.ق.
224. وفادار المرادي، محمّد، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي (فهرس الكتب الخطية للمكتبة المركزية ومركز وثائق العتبة الرضوية المقدّسة)، مشهد المقدّسة ـ إيران، المكتبة المركزية ومركز وثائق العتبة الرضوية المقدّسة، 1376 ﻫ.ش.
225. الولائي، محمّد، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي (فهرس الكتب الخطية للمكتبة المركزية التابعة للعتبة الرضوية المقدّسة)، مشهد المقدسة ـ إيران، 1344 ﻫ.ش.
226. اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، تاريخ اليعقوبي، بيروت ـ لبنان، دار صادر، بلا تاريخ.
[1] البقرة: آية31.
[2]الفيض الكاشاني، محمّد، المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء: ج1، ص 111.
[3] المجادلة: آية11.
[4] البقرة: آية129.
[5] آل عمران: آية164.
[6] الكفعمي، إبراهيم بن علي، المصباح: ص280.
[7] البقرة: آية253.
[8] طه: آية12.
[9][9] النساء: آية59.
[10] النحل: آية44.
[11] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ج1، ص201 ـ 202، حديث605.
[12] الأحزاب: آية36.
[13] العياشي، محمّد بن مسعود، تفسير العياشي: ج1، ص252، حديث173.
[14] أبو حيان، محمّد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير: ج3، ص686 ـ 687.
[15] الفخر الرازي، محمّد بن عمر، التفسير الكبير: ج10، ص113.
[16] المصدر السابق.
[17] النحل: آية44.
[18] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج9، ص81، حديث7222.
[19] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص130، حديث4617.
[20] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص662، حديث3786.
[21] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص253، حديث3.
[22] الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي: ص121، حديث188.
[23] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص276، حديث1.
[24] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، علل الشرائع: ج1، ص124، حديث1.
[25] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص222، حديث8.
[26] الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج1، ص189، حديث202.
[27] الحموي الجويني، إبراهيم بن محمّد، فرائد السمطين: ج1، ص314 ـ 315، حديث250.
[28] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج9، ص81، حديث7222.
[29] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج3، ص1452، حديث1821.
[30] المصدر السابق.
[31] المصدر السابق: ص1453، حديث1821.
[32] المصدر السابق.
[33] المصدر السابق: حديث1822.
[34] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج2، ص196، حديث1794.
[35] المصدر السابق: حديث1796.
[36] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج34، ص449، حديث20880.
[37] المصدر السابق: ص476، حديث20937.
[38] المصدر السابق: ص477، حديث20939.
[39] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص280، حديث29.
[40] خزاز الرازي، علي بن محمّد، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر: ص173.
[41] المصدر السابق: ص197.
[42] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص298، حديث5.
[43] خزاز الرازي، علي بن محمّد، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر: ص223.
[44] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص530 ـ 531، حديث6.
[45] المصدر السابق: ص533، حديث16.
[46] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ج2، ص338 ـ 339، حديث14.
[47] القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص292 ـ 293.
[48] الحموي الجويني، إبراهيم بن محمّد، فرائد السمطين: ج2، ص133 ـ 134، حديث431.
[49] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص525 ـ 526، حديث1.
[50] المصدر السابق: ص527 ـ 528، حديث3.
[51] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص30.
[52] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص297 ـ 298، حديث1.
[53] المصدر السابق: ص300، حديث1.
[54] الأحزاب: آية33.
[55] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص1883، حديث2424.
[56] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص699، حديث3871.
[57] المصدر السابق: ص351، حديث3205.
[58] المصدر السابق: ص352، حديث3206.
[59] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج44، ص118 ـ 119، حديث26508.
[60] النحل: آية43، الأنبياء: آية7.
[61] الزخرف: آية44.
[62] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص210، حديث2.
[63] المصدر السابق: حديث3.
[64] الطلاق: آية10 ـ 11.
[65] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، الأمالي: ص624 ـ 625.
[66] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص295، حديث3.
[67] الطلاق: آية10 ـ 11.
[68] النحل: آية44.
[69] الحجر: آية9.
[70] الراغب الإصفهاني، حسين بن محمّد، مفردات ألفاظ القرآن: ص328.
[71] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج5، ص298، حديث5365.
[72] الواقعة: آية77 ـ 79.
[73] الأحزاب: آية33.
[74] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص1883، حديث2424.
[75] الحسكاني، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج1، ص432، حديث459.
[76] الرعد: آية43.
[77] نظام الأعرج النيسابوري، الحسن بن محمّد، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج4، ص167.
[78] البغوي، حسين بن مسعود، تفسير البغوي المسمّى معالم التنزيل: ج3، ص5.
[79] النمل: آية40.
[80] الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج6، ص419.
[81] الواقعة: آية77 ـ 79.
[82] الأحزاب: آية33.
[83] النحل: آية44.
[84] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص229، حديث6.
[85] الحسكاني، عبيد الله بن أحمد، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل: ج1، ص400، حديث422.
[86] آل عمران: آية103.
[87] الفيومي، أحمد بن محمّد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: ص414.
[88] ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج4، ص331.
[89] آل عمران: آية101.
[90] آل عمران: آية101.
[91] النساء: آية146.
[92] الحج: آية78.
[93] النساء: آية80.
[94] الحشر: آية7.
[95] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج17، ص211 ـ 212، حديث11131.
[96] فصلت: آية42.
[97] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر ، جامع الأحاديث: ج4، ص82، حديث10317.
[98] الأحزاب: آية33.
[99] الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج2، ص805.
[100] الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي: ص272، حديث510.
[101] العياشي، محمّد بن مسعود، تفسير العياشي: ج1، ص194، حديث123.
[102] الثعلبي، أحمد بن محمّد، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ج3، ص163.
[103] الواقعة: آية77 ـ 79.
[104] البقرة: آية236.
[105] الأعراف: آية201.
[106] المدثر: آية4.
[107] آل عمران: آية42.
[108] الأحزاب: آية33.
[109] العنكبوت: آية49.
[110] الرعد: آية43.
[111] الواقعة: آية77 ـ 79.
[112] الأحزاب: آية33.
[113] البقرة: آية124.
[114] النساء: آية59.
[115] يوسف: آية33.
[116] فاطر: آية32.
[117] الواقعة: آية77 ـ 79.
[118] الأحزاب: آية33.
[119] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص1873، حديث2408.
[120] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج35، ص456، حديث21578.
[121] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص662، حديث3786.
[122] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص118، حديث4577.
[123] المصدر السابق: ج2، ص373، حديث3312.
[124] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الصغير: ج1، ص240، حديث391.
[125] ابن الأثير، المبارك بن محمّد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص298.
[126] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص162، حديث4715.
[127] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمّد، الصواعق المحرقة: ج2، ص675.
[128] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، فضائل الصحابة: ج2، ص671، حديث1145.
[129] أبو داود السجستاني، سليمان بن أشعث، سنن أبي داود: ج3، ص318، حديث3646؛ الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي: ج1، ص429، حديث501؛ ابن حنبل، أحمد ابن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج11، ص57 ـ 58، حديث6510.
[130] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج19، ص441، حديث12457.
[131] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج1، ص34، حديث114.
[132] الذهبي، محمّد بن أحمد، تذكرة الحفاظ: ج1، ص9.
[133] المصدر السابق: ص10 ـ 11.
[134] ابن سعد، محمّد بن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص143.
[135] الذهبي، محمّد بن أحمد، تذكرة الحفاظ: ج1، ص12.
[136] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص106.
[137] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج1، ص193، حديث374.
[138] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج2، ص718، حديث1037؛ ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج28، ص115، حديث16910.
[139] النحل: آية44.
[140] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص441، حديث5.
[141] الطوسي، محمّد بن الحسن، الغيبة: ص247.
[142] الشهرستاني، محمّد بن عبد الكريم، الملل والنحل: ج1، ص236.
[143] المائدة: آية3.
[144] يوسف: آية40.
[145] المائدة: آية48.
[146] الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن: ج6، ص28.
[147] النساء: آية176.
[148] أبو حيان، محمّد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير: ج4، ص175.
[149] الشورى: آية23.
[150] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص47، حديث2641؛ ابن حنبل، أحمد بن محمّد، فضائل الصحابة: ج2، ص669، حديث1141؛ الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج9، ص168، حديث14978.
[151] الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن: ج25، ص16.
[152] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص188، حديث4802.
[153] آل عمران: آية31.
[154] طه: آية90.
[155] العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وكشف الصدق: ص175.
[156] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمّد، الصواعق المحرقة: ج1، ص187.
[157] آل عمران: آية61.
[158] الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج2، ص762.
[159] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص432.
[160] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج3، ص160، حديث1608.
[161] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص1871، حديث2404.
[162] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص638، حديث3724.
[163] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص163، حديث4719.
[164] الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن: ج3، ص212.
[165] المفيد، محمّد بن محمّد، الفصول المختارة: ص38.
[166] البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ج2، ص20.
[167] الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج1، ص368 ـ 369.
[168] الإنسان: آية8 ـ 9.
[169] الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ج4، ص670.
[170] الإنسان: آية1.
[171] الإنسان: آية5.
[172] الإنسان: آية8.
[173] ابن عبد ربّه، أحمد بن محمّد، العقد الفريد: ج5، ص354.
[174] النصيبي الشافعي، محمّد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ص127 ـ 28.
[175] ابن الجوزي، يوسف بن قزأوغلي، تذكرة الخواص: ص284.
[176] المصدر السابق: ص281.
[177] القرطبي، محمّد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن: ج19، ص130.
[178] النسفي، عبد الله بن أحمد، مدارك التنزيل وحقائق التأويل: ج4، ص466.
[179] نظام الأعرج النيسابوري، الحسن بن محمّد، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: ج6، ص412.
[180] الآلوسي، محمود بن عبد الله، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ج15، ص174.
[181] البقرة: آية37.
[182] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج1، ص147.
[183] الفيومي، أحمد بن محمّد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: ص672.
[184] الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية: ج6، ص2528 ـ 2530.
[185] الشرتوني، سعيد، أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد: ج2، ص1487.
[186] الراغب الإصفهاني، حسين بن محمّد، مفردات ألفاظ القرآن: ص885.
[187] الطباطبائي، محمّد حسين، رسالة الولاية: ص4.
[188] الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج10، ص88 ـ 89.
[189] يوسف: آية93.
[190] يوسف: آية96.
[191] البقرة: آية60.
[192] النمل: آية38.
[193] النمل: آية40.
[194] آل عمران: آية49.
[195] القمر: آية1 ـ 2.
[196] الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج9، ص281 ـ 282.
[197] النمل: آية40.
[198] الرعد: آية43.
[199] الواقعة: آية77 ـ 79.
[200] الأحزاب: آية33.
[201] النحل: آية44.
[202] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص1883، حديث2424.
[203] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص699، حديث3871.
[204] المصدر السابق: ص351، حديث3205.
[205] المصدر السابق: ص352، حديث3206.
[206] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج44، ص118ـ 119، حديث26508.
[207] المناوي، محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج1، ص225، حديث311.
[208] الآمدي، عبد الواحد بن محمّد، غرر الحكم ودرر الكلم: ص217، حديث538.
[209] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص664، حديث3789.
[210] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص154.
[211] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج8، ص129، حديث98.
[212] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج43، ص241.
[213] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص46، حديث2.
[214] الإربلي، علي بن عيسى، كشف الغمّة في معرفة الأئمة: ج1، ص53؛ الشبلنجي، مؤمن، نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار|: ص231.
[215] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه ، الأمالي: ص414، حديث542، الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج6، ص59، حديث5790.
[216] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص288.
[217] الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي: ص455 ـ 456، حديث1018.
[218] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص62، حديث258.
[219] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج11، ص102، حديث11177.
[220] البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج2، ص210 ـ 211، حديث2852.
[221] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج1، ص128، حديث631؛ الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، سنن الدارمي: ج2، ص796 ـ 797، حديث1288.
[222] الدارقطني، علي بن عمر بن أحمد، سنن الدارقطني: ج2، ص171، حديث1343.
[223] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج28، ص304، حديث17072.
[224] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج1، ص402، حديث991.
[225] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج1، ص305، حديث405.
[226] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج6، ص121، حديث4798.
[227] الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن: ج22، ص31.
[228] المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج2، ص274، حديث3993.
[229] النسائي، أحمد بن شعيب، سنن النسائي: ج3، ص48، حديث1290.
[230] المصدر السابق: ص48 ـ 49، حديث1292.
[231] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج38، ص92، حديث22988.
[232] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج53، ص309.
[233] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمّد، الصواعق المحرقة: ج2، ص430.
[234] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص146، حديث3370.
[235] الطحاوي، أحمد بن محمّد، شرح مشكل الآثار: ج6، ص14، حديث2240.
[236] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص1883، حديث2424.
[237] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص351، حديث3205.
[238] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج3، ص160، حديث1608.
[239] الفخر الرازي، محمّد بن عمر، التفسير الكبير: ج27، ص595.
[240] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص160، حديث4710.
[241] البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى: ج2، ص212.
[242] النصيبي الشافعي، محمّد بن طلحة، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: ص37.
[243] ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية: ج7، ص75.
[244] ابن الأثير، المبارك بن محمّد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص81.
[245] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص162، حديث4717.
[246] السقاف، حسن بن علي، صحيح شرح العقيدة الطحاوية: ص659.
[247] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج15، ص436، حديث9698؛ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص40، حديث2621.
[248] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص641 ـ 642، حديث3733؛ ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج2، ص18، حديث576.
[249] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط: ج5، ص348، حديث5514.
[250] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج5، ص27، حديث3753؛ الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص657، حديث3770.
[251] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج38، ص211، حديث23133.
[252] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج9، ص179، حديث15064.
[253] ابن حبان، محمّد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان: ج15، ص427، حديث6970.
[254] الألباني، محمّد ناصرالدين، صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: ج2، ص367، حديث1881.
[255] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج15، ص420، حديث9673؛ الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص182، حديث4777.
[256] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج9، ص179، حديث15063.
[257] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص656، حديث3769.
[258] ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج2، ص255.
[259] الألباني، محمّد ناصرالدين، صحيح الجامع الصغير وزياداته: ج2، ص1175، حديث7003.
[260] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج9، ص180، حديث15071.
[261] المصدر السابق: ص181، حديث15071.
[262] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص179، حديث4770.
[263] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج22، ص423، حديث1042.
[264] السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جامع الأحاديث: ج5، ص73، حديث17273.
[265] أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي، مسند أبي يعلى: ج12، ص109، حديث6741.
[266] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص181، حديث4776.
[267] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص657 ـ 658، حديث3772.
[268] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج1، ص150.
[269] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص182، حديث4780.
[270] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص132.
[271] البزار، أحمد بن عمرو، البحر الزخار المعروف بمسند البزار: ج3، ص102، حديث885.
[272] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص195، حديث4821.
[273] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص206.
[274] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص658 ـ 659، حديث3775؛ ابن ماجة، محمّد بن يزيد، سنن ابن ماجة: ج1، ص51، حديث144.
[275] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص194، حديث4820.
[276] البوصيري، أحمد بن أبي بكر، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: ج1، ص22.
[277] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج9، ص181، حديث15075.
[278] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص150.
[279] الهيثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج9، ص201، حديث15188.
[280] الحاكم النيسابوري، محمّد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص195، حديث4821.
[281] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص637، حديث3722.
[282] ابن المغازلي، علي بن محمّد، مناقب أهل البيت^: ص320.
[283] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص637، حديث3723.
[284] المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج13، ص114، حديث36372.
[285] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص290، حديث1.
[286] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص58، حديث21.
[287] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص299، حديث2.
[288] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص53، حديث14.
[289] الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي: ص441، حديث989.
[290] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص146، حديث20.
[291] المصدر السابق: ص147، حديث2.
[292] المصدر السابق: ص145، حديث19.
[293] المصدر السابق: ص144، حديث8.
[294] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص297، حديث1.
[295] الطوسي، محمّد بن الحسن، الغيبة: ص195 ـ 196.
[296] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص305، حديث2.
[297] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص167، حديث20.
[298] محمّد بن إبراهيم النعماني، الغيبة: ص327، حديث4.
[299] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص164، حديث7.
[300] المصدر السابق: ص162، حديث2.
[301] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج7، ص113، حديث5.
[302] البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري: ج4، ص69، حديث3047.
[303] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص156، حديث14.
[304] الكهف: آية65.
[305] الكهف: آية66.
[306] النمل: آية40.
[307] الرعد: آية43.
[308] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص186.
[309] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص258، حديث2.
[310] الأنعام: آية59.
[311] الجن: آية26 ـ 27.
[312] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص267، حديث9.
[313] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص2217، حديث2891.
[314] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج38، ص446 ـ 447، حديث23460.
[315] ابن العماد، عبد الحي بن أحمد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ج7، ص31.
[316] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج1، ص393.
[317] مخلوف المالكي، محمّد بن محمّد، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: ج2، ص106.
[318] الواقعة: آية77 ـ 79.
[319] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص58، حديث21.
[320] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص299، حديث2.
[321] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص53، حديث14.
[322] الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي: ص441، حديث989.
[323] الصفار، محمّد بن الحسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين: ص162، حديث1.
[324] المصدر السابق: ص167، حديث20.
[325] المصدر السابق: ص162، حديث2.
[326] المصدر السابق: ص10، حديث4.
[327] المصدر السابق: ص9، حديث1.
[328] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص398، حديث1.
[329] النور: آية35.
[330] النساء: آية174.
[331] الواقعة: آية77 ـ 79.
[332] البقرة: آية236.
[333] الأعراف: آية201.
[334] المدثر: آية4.
[335] آل عمران: آية42.
[336] الأحزاب: آية33.
[337] العنكبوت: آية49.
[338] الرعد: آية43.
[339] الواقعة: آية77 ـ 79.
[340] الأحزاب: آية33.
[341] البقرة: آية124.
[342] النساء: آية59.
[343] يوسف: آية33.
[344] فاطر: آية32.
[345] الواقعة: آية77 ـ 79.
[346] الأحزاب: آية33.
[347] الفيومي، أحمد بن محمّد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: ص194.
[348] البقرة: آية186.
[349] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص467 ـ 468، حديث8.
[350] أخذنا بعض هذه العناوين من كتاب الصحيفة الحسينية الكاملة لمحمّد صادق الكرباسي.
[351] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص339 ـ 350.
[352] الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251 ـ 258.
[353] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج95، ص216 ـ 227، حديث3.
[354] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، زاد المعاد: ص173 ـ 182.
[355] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج95، ص214.
[356] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص348.
[357] المصدر السابق.
[358] المصدر السابق: ص350.
[359] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص267 ـ 271.
[360] الكفعمي، إبراهيم بن علي، المصباح: ص209 ـ 213.
[361] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج92، ص236 ـ 240.
[362] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص267.
[363] روملو، حسن، أحسن التواريخ: ج3، ص1225.
[364] الأفندي، عبد الله بن عيسى بيك، رياض العلماء وحياض الفضلاء: ج3، ص453.
[365] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج8، ص209.
[366] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149 ـ 151.
[367] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج92، ص412 ـ 415.
[368] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص149.
[369] المصدر السابق.
[370] ابن طاووس، علي بن موسى، جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: ص271 ـ 274.
[371] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج88، ص186 ـ 187.
[372] ابن طاووس، علي بن موسى، جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: ص271.
[373] المصدر السابق.
[374] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص298.
[375] الكفعمي، إبراهيم بن علي، المصباح: ص215.
[376] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج91، ص374.
[377] آقابزرگ الطهراني، محمّد محسن، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ج8، ص186 ـ 187.
[378] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص298.
[379] الطوسي، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجد: ج2، ص827.
[380] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص690.
[381] الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص186.
[382] الكفعمي، إبراهيم بن علي، المصباح: ص544.
[383] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج98، ص348.
[384] الطوسي، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجد: ج2، ص828.
[385] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص690.
[386] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص184.
[387] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ج1، ص537 ـ 538، حديث1504.
[388] الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص157 ـ 158، حديث576.
[389] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ج1، ص537، حديث1504.
[390] ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، عيون الأخبار: ج2، ص303.
[391] القطب الراوندي، سعيد بن هبة الله، الدعوات: ص92.
[392] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج91، ص206، حديث3.
[393] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص157 ـ 158.
[394] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج83، ص313، حديث65.
[395] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص157.
[396] الكفعمي، إبراهيم بن علي، المصباح: ص304.
[397] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص157.
[398] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج91، ص191، حديث5.
[399] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص96.
[400] ابن سعد، محمّد بن سعد، الـطبقات الكبرى: الطبقة الخامسة من الصحابة: ج1، ص468.
[401] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص423.
[402] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص96.
[403] ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل في التاريخ: ج3، ص169.
[404] الذهبي، محمّد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج3، ص301.
[405] ابن كثير، إسماعيل بن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص169 ـ 170.
[406] ابن عساكر، علي بن الحسن، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص217.
[407] الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق: ص406.
[408] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج92، ص95، حديث6.
[409] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص221.
[410] الحموي الجويني، إبراهيم بن محمّد، فرائد السمطين: ج2، ص262.
[411] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص221.
[412] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص11.
[413] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج91، ص265، حديث3.
[414] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، عيون أخبار الرضا×: ج1، ص60، حديث29.
[415] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص265، حديث11.
[416] الكفعمي، إبراهيم بن علي، المصباح: ص304.
[417] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص265، حديث11.
[418] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج36، ص205، حديث8.
[419] الإربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج2، ص63.
[420] ابن بسطام، عبد الله، ابن بسطام، حسين، طب الأئمة^: ص34.
[421] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج92، ص85، حديث1.
[422] ابن صباغ، علي بن محمّد، الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج2، ص918.
[423] الشبلنجي، مؤمن، نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار|، ص296.
[424] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص184.
[425] الإربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج2، ص168.
[426] الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص526.
[427] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج101، ص282، حديث20.
[428] ابن صباغ، علي بن محمّد، الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج2، ص918.
[429] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص48 ـ 49.
[430] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج82، ص214.
[431] ابن طاووس، علي بن موسى، مهج الدعوات ومنهج العبادات: ص49.
[432] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج82، ص214.
[433] ابن بسطام، عبد الله، ابن بسطام، حسين، طب الأئمة^: ص116.
[434] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج92، ص220، حديث17.
[435] المصدر السابق: ج99، ص301، حديث31.
[436] ابن سعد، محمّد بن سعد، الـطبقات الكبرى: الطبقة الخامسة من الصحابة: ج1، ص409، حديث383.
[437] ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمّد، المصنف في الأحاديث والآثار: ج6، ص89، حديث29706.
[438] المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج8، ص82، حديث21992.
[439] ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمّد، المصنف في الأحاديث والآثار: ج6، ص89، حديث29706.
[440] الحلواني، الحسين بن محمّد، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص83، حديث10.
[441] الآبي، منصور بن الحسين، نثر الدر في المحاضرات: ج1، ص230.
[442] الإربلي، علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج2، ص31.
[443] الشهيد الأوّل، محمّد بن مكي، الدرة الباهرة من الأصداف الطاهرة: ص23، حديث47.
[444] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج75، ص127، حديث9.
[445] الحلواني، الحسين بن محمّد، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص83، حديث10.
[446] الزمخشري، محمود بن عمر، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: ج2، ص305.
[447] ابن شهرآشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب^: ج4، ص148.
[448] الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص399.
[449] القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص82.
[450] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص418.
[451] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص91.
[452] الفتال النيسابوري، محمّد بن الحسن، روضة الواعظين: ج1، ص183.
[453] الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص455.
[454] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج44، ص392.
[455] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص91.
[456] ابن شعبة، الحسن بن علي، تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم: ص239.
[457] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج97، ص80 ـ 81، حديث37.
[458] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص405.
[459] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص83.
[460] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص336.
[461] ابن نما، جعفر بن محمّد، مثير الأحزان: ص44.
[462] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص47.
[463] ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل في التاريخ: ج3، ص160.
[464] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص242.
[465] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج44، ص382.
[466] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص83.
[467] المصدر السابق: ص31.
[468] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص284.
[469] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص171.
[470] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص31.
[471] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص293.
[472] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص23.
[473] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص293.
[474] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص443.
[475] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص299.
[476] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص29.
[477] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص299.
[478] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص430.
[479] ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل في التاريخ: ج3، ص173.
[480] ابن نما، جعفر بن محمّد، مثير الأحزان: ص62.
[481] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص63.
[482] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص286.
[483] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص17.
[484] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص430.
[485] ابن نما، جعفر بن محمّد، مثير الأحزان: ص29.
[486] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص28.
[487] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص176.
[488] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج44، ص339.
[489] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص28.
[490] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص439.
[491] ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل في التاريخ: ج3، ص176.
[492] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص439.
[493] المصدر السابق: ص445.
[494] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص29.
[495] ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل في التاريخ: ج3، ص179.
[496] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص300.
[497] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص30.
[498] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص445.
[499] المصدر السابق: ص448.
[500] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص108.
[501] الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص466.
[502] ابن نما، جعفر بن محمّد، مثير الأحزان: ص70.
[503] الشامي، يوسف بن حاتم، الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم: ص556.
[504] ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل في التاريخ: ج3، ص181.
[505] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص314.
[506] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص47.
[507] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص108.
[508] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص32.
[509] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص305.
[510] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص36.
[511] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص305.
[512] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص114.
[513] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص34.
[514] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص310 ـ 311.
[515] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص42 ـ 43.
[516] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص310 ـ 311.
[517] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص60.
[518] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص277 ـ 278.
[519] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص10.
[520] المصدر السابق.
[521] ابن نما، جعفر بن محمّد، مثير الأحزان: ص69.
[522] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص446.
[523] المفيد، محمّد بن محمّد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: ج2، ص106.
[524] الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص464.
[525] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص36.
[526] ابن نما، جعفر بن محمّد، مثير الأحزان: ص69.
[527] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص68.
[528] الشامي، يوسف بن حاتم، الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم: ص555.
[529] ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل في التاريخ: ج3، ص179.
[530] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص185.
[531] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص313.
[532] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص44.
[533] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص117 ـ 118.
[534] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص38.
[535] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص319.
[536] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص52.
[537] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص319.
[538] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص75، حديث2.
[539] الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص59 ـ 60، حديث190.
[540] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص188 ـ 189، حديث2.
[541] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه: ج1، ص168، حديث490.
[542] الطوسي، محمّد بن الحسن، تهذيب الأحكام: ج3، ص197، حديث453.
[543] الحر العاملي، محمّد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج3، ص71 ـ 72، حديث3044.
[544] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج44، ص202 ـ 203، حديث20.
[545] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج3، ص188 ـ 189، حديث2.
[546] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص114.
[547] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج2، ص35.
[548] الحائري الكركي، محمّد بن أبي طالب، تسلية المُجالس وزينة المَجالس: ج2، ص311.
[549] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص43.
[550] المصدر السابق.
[551] ابن شهرآشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب^: ج4، ص56 ـ 57.
[552] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج45، ص301.
[553] ابن شهرآشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب^: ج4، ص56 ـ 57.
[554] المصدر السابق: ص57.
[555] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، الأمالي: ص222.
[556] ابن شهرآشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب^: ج4، ص57 ـ 58.
[557] أخطب خوارزم، الموفق بن أحمد، مقتل الحسين×: ج1، ص352.
[558] الفتال النيسابوري، محمّد بن الحسن، روضة الواعظين: ج1، ص185.
[559] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج44، ص317.
[560] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، الأمالي: ص222.
[561] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص339 ـ 350.
[562] المصدر السابق: ص339.
[563] المصدر السابق: ص348.
[564] المصدر السابق: ص350.
[565] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج95، ص214.
[566] المصدر السابق.
[567] النوري، حسين بن محمّد تقي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج10، ص25، حديث11370.
[568] الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251 ـ 258.
[569] النوري، حسين بن محمّد تقي، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: ج10، ص25 ـ 26، حديث11370.
[570] الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251.
[571] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، زاد المعاد: ص173 ـ 182.
[572] القمي، عباس، كليات مفاتيح الجنان: ص261 ـ 274.
[573] حامد خاني، دفاع از اصالت ادعيه اهل بيت^: مطالعه موردي دعاي عرفه الدفاع عن أصالة أدعية أهل البيت^: دراسة حول دعاء عرفة، حديث پژوهي، رقم: 10، 1392 ﻫ.ش، ص65 ـ 66.
[574] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص317.
[575] ابن إدريس، محمّد بن أحمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى: ج3، ص289.
[576] الحر العاملي، محمّد بن الحسن، أمل الآمل في علماء جبل عامل: ج2، ص69، رقم 190.
[577] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج7، ص438.
[578] الحسيني الإشكوري، جعفر، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مدرسه جعفريه: زهان ـ إيران فهرس النسخ الخطية لمكتبة المدرسة الجعفرية: زهان ـ إيران: ص51.
[579] دانش پژوه، محمّد تقي، أفشار، إيرج، فهرست كتابهاي خطي كتابخانه ملي ملك وابسته به آستان قدس رضوي فهرس الكتب الخطية لمكتبة ملك الوطنية التابعة للعتبة الرضوية المقدّسة: ج1، ص43.
[580] رخشاد، محمّد حسين، در محضر حضرت آيت الله العظمى بهجت بين يدي آية الله العظمى بهجت: ج2، ص411، رقم 1268.
[581] الكرباسجي، محمّد مهدي، بررسي متن، سند، شروح ونسخ خطي مصادر اوليه قسمت دوم دعاي عرفه سيد الشهداء× دراسة في إسناد القسم الثاني من دعاء عرفة لسيّد الشهداء× ونصّه وشروحه ومخطوطات مصادره الأولى، رسالة ماجستير في فرع علوم الحديث: ص25ـ 38.
[582] الحسيني الإشكوري، أحمد، فهرست نسخه هاي خطي مركز احياء ميراث اسلامي فهرس النسخ الخطية لمركز إحياء التراث الإسلامي: ج6، ص95.
[583] وفادار المرادي، محمّد، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي فهرس الكتب الخطية للمكتبة المركزية ومركز وثائق العتبة الرضوية المقدّسة: ج15، ص118.
[584] الصدرائي الخوئي، علي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي فهرس النسخ الخطية لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي: ج35، ص332.
[585] فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي فهرس الكتب الخطية للمكتبة المركزية التابعة للعتبة الرضوية المقدّسة: ج6، ص212.
[586] دانش پژوه، محمّد تقي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران فهرس النسخ الخطية للمكتبة المركزية في جامعة طهران: ج16، ص99.
[587] أنوار، عبد الله، فهرست نسخ خطي كتابخانه ملي ايران فهرس النسخ الخطية لمكتبة إيران الوطنية: ج8، ص14.
[588] الحسيني الإشكوري، أحمد، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آيت الله العظمى نجفي مرعشي فهرس النسخ الخطية لمكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي العامة: ج4، ص121.
[589] دانش پژوه، محمّد تقي، أفشار، إيرج، فهرست كتابهاي خطي كتابخانه ملي ملك وابسته به آستان قدس رضوي فهرس الكتب الخطية لمكتبة ملك الوطنية التابعة للعتبة الرضوية المقدّسة: ج1، ص55.
[590] الحائري، عبد الحسين، فهرست كتابخانه مجلس شوراي ملي فهرس مكتبة مجلس الشورى الوطني: ج4/10، ص1933.
[591] الحسيني الإشكوري، أحمد، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آيت الله العظمى نجفي مرعشي فهرس النسخ الخطية لمكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي العامة: ج16، ص226.
[592] المصدر السابق: ج3، ص342.
[593] المصدر السابق: ج6، ص181.
[594] وفادار المرادي، محمّد، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي فهرس الكتب الخطية للمكتبة المركزية ومركز وثائق العتبة الرضوية المقدّسة: ج15، ص119.
[595] عرب زادة، أبو الفضل، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمى گلپايگانى فهرس النسخ الخطية لمكتبة آية الله العظمى الگلپايگاني العامة: ص94.
[596] دانش پژوه، محمّد تقي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران فهرس النسخ الخطية للمكتبة المركزية في جامعة طهران: ج17، ص340.
[597] عرب زادة، أبو الفضل، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمى گلپايگانى فهرس النسخ الخطية لمكتبة آية الله العظمى الگلپايگاني العامة: ص94.
[598] الحجتي، محمّد باقر، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه دانشكده الهيات ومعارف اسلامي دانشگاه تهران فهرس النسخ الخطية لمكتبة كلية الإلهيات والمعارف الإسلامية في جامعة طهران: ج1، ص459.
[599] الحسيني الإشكوري، أحمد، فهرست نسخه هاي خطي مركز احياء ميراث اسلامي فهرس النسخ الخطية لمركز إحياء التراث الإسلامي: ج7، ص109.
[600] فاضل، محمود، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جامع گوهرشاد مشهد فهرس النسخ الخطية لمكتبة جامع گوهرشاد في مشهد: ج1، ص155.
[601] الصدرائي الخوئي، علي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي فهرس النسخ الخطية لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي: ج35، ص366.
[602] مقصود الهمداني، جواد، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه غرب مدرسه آخوند ـ همدان فهرس النسخ الخطية لمكتبة غرب مدرسة آخوند ـ همدان: ص60.
[603] فاضل، محمود، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه جامع گوهرشاد مشهد فهرس النسخ الخطية لمكتبة جامع گوهرشاد في مشهد: ج1، ص78.
([604] حسينيان القمي، مهدي، (دفاع از بخش پاياني دعاي عرفه امام حسين× (الدفاع عن القسم الأخير من دعاء الإمام الحسين× في عرفة، سمات، رقم: 5، 1390 ﻫ.ش، ص57.
[605] سعادت پرور، علي، نور هدايت نور الهداية: ج3، ص200.
[606] رخشاد، محمّد حسين، در محضر حضرت آيت الله العظمى بهجت بين يدي آية الله العظمى بهجت: ج2، ص411، رقم 1268.
[607] الشبيري الزنجاني، موسى، جرعه اي از دريا رشفة من بحر: ج3، ص256.
[608] مكارم الشيرازي، ناصر، كليات مفاتيح نوين: ص878.
[609] ابن طاووس، علي بن موسى، سعد السعود للنفوس: ص65 ـ 66.
[610] المصدر السابق: ص70.
[611] كولبرغ، إيتان، كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او مكتبة ابن طاووس وأحواله وآثاره، ترجمة: جعفريان، رسول، قرائي، علي: ص70.
[612] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص15.
[613] المصدر السابق: ج2، ص586.
[614] الشعراني، أبو الحسن، دعاي عرفه حضرت أبا عبد الله الحسين× دعاء عرفة لأبي عبد الله الحسين×: ص4.
[615] وفادار المرادي، محمّد، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي فهرس الكتب الخطية للمكتبة المركزية ومركز وثائق العتبة الرضوية المقدّسة: ج15، ص119.
[616] الكرباسجي، محمّد مهدي، بررسي متن، سند، شروح ونسخ خطي مصادر اوليه قسمت دوم دعاي عرفه سيد الشهداء× دراسة في إسناد القسم الثاني من دعاء عرفة لسيّد الشهداء× ونصّه وشروحه ومخطوطات مصادره الأولى: ص27.
[617] القمي، عباس، كليات مفاتيح الجنان: ص260.
[618] المصدر السابق: ص271.
[619] المصدر السابق: ص12.
[620] المصدر السابق: ص434.
[621] السيستاني، علي، مناسك حج: ص394 ـ 404.
[622] بهجت، محمّد تقي، مناسك حج وعمره: ص261 ـ 264.
[623] الخامنئي، علي، مناسك الحج: ص190 ـ 195.
[624] الوحيد الخراساني، حسين، مناسك حج: ص318 ـ 323.
[625] الشبيري الزنجاني، موسى، مناسكك الحج: ص428 ـ 432.
[626] مكارم الشيرازي، ناصر، مناسك جامع حج: ص461 ـ 464.
[627] السبحاني التبريزي، جعفر، مناسك الحج واحكام العمرة: ص183 ـ 187.
[628] الحسيني الحائري، كاظم، مناسك الحج: ص199 ـ 203.
[629] الفياض، محمّد إسحاق، مناسك الحج: ص280 ـ 283.
[630] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص728.
[631] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج95، ص214.
[632] المصدر السابق: ص227 ـ 228.
[633] الكفعمي، إبراهيم بن علي، البلد الأمين: ص251 ـ 258.
[634] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، زاد المعاد: ص173 ـ 182.
[635] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص339 ـ 350.
[636] القمي، عباس، كليات مفاتيح الجنان: ص271 ـ 274.
[637] آقابزرگ الطهراني، محمّد محسن، طبقات أعلام الشيعة: ج4، ص117.
[638] حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ج1، ص675.
[639] الحسيني الطهراني، محمّد حسين، معرفة الله، ترجمة: الصافي، عباس جواد: ج1، ص264 ـ 269.
[640] الكرباسجي، محمّد مهدي، بررسي متن، سند، شروح ونسخ خطي مصادر اوليه قسمت دوم دعاي عرفه سيد الشهداء× دراسة في إسناد القسم الثاني من دعاء عرفة لسيّد الشهداء× ونصّه وشروحه ومخطوطات مصادره الأولى: ص128.
[641] القمي، عباس، كليات مفاتيح الجنان: ص271.
[642] الحسيني الطهراني، محمّد حسين، معرفة المعاد، ترجمة: مبارك، عبد الرحيم: ج5، ص65.
[643] المصدر السابق: ص65 ـ 66.
[644] الحسيني الطهراني، محمّد حسين، نور ملكوت القرآن، ترجمة: حسن إبراهيم: ج4، ص59 ـ 60.
[645] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج95، ص227 ـ 228.
[646] وفادار المرادي، محمّد، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي فهرس الكتب الخطية للمكتبة المركزية ومركز وثائق العتبة الرضوية المقدّسة: ج15، ص119.
[647] الكرباسجي، محمّد مهدي، بررسي متن، سند، شروح ونسخ خطي مصادر اوليه قسمت دوم دعاي عرفه سيد الشهداء× دراسة في إسناد القسم الثاني من دعاء عرفة لسيد الشهداء× ونصّه وشروحه ومخطوطات مصادره الأولى: ص27.
[648] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج95، ص227.
[649] المصدر السابق: ج64، ص142.
[650] الصدرائي الخوئي، علي، فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي فهرس النسخ الخطية لمكتبة مجلس الشورى الإسلامي: ج35، ص332.
[651] الكرباسجي، محمّد مهدي، بررسي متن، سند، شروح ونسخ خطي مصادر اوليه قسمت دوم دعاي عرفه سيد الشهداء× دراسة في إسناد القسم الثاني من دعاء عرفة لسيّد الشهداء× ونصّه وشروحه ومخطوطات مصادره الأولى: ص26.
[652] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج95، ص227 ـ 228.
[653] همائي، جلال الدين، مولوي نامه؛ مولوي چه مي گويد؟ الرسالة المولوية؛ مولوي ماذا يقول؟: ج2، ص18.
[654] الشبيري الزنجاني، موسى، جرعه اي از دريا رشفة من بحر: ج3، ص256 ـ 258.
[655] آقابزرگ الطهراني، محمّد محسن، طبقات أعلام الشيعة: ج4، ص117.
[656] حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: ج1، ص675.
[657] الحسيني الطهراني، محمّد حسين، معرفة المعاد: ج5، ص66.
[658] الصدرائي الخوئي، علي، ذيل دعاي عرفه ذيل دعاء عرفة، اسفند 1385 ﻫ.ش، http://sadraiy.blogfa.com/post-73.aspx.
[659] الصدرائي الخوئي، علي، بخش دوم دعاي عرفه هم جزو دعا ومنتسب به سيد الشهداء× است القسم الثاني من دعاء عرفة جزء من الدعاء ولسيّد الشهداء×، مرداد 1392 ﻫ.ش، http://shafaqna.com/persian/services/dialogue/item/54589ـ حجت ـ الاسلام ـ صدرايي ـ خوئي ـ بخش ـ دوم ـ دعاي ـ عرفه ـ هم ـ جزو ـ دعا ـ وـ منتسب ـ به ـ سيدالشهدا ـ است/.
[660] المصدر السابق.
[661] النحل: آية18.
[662] النحل: آية53.
[663] أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج9، ص332 ـ 333.
[664] ابن عجيبة، أحمد، إيقاظ الهمم في شرح الحكم: ص544.
[665] سعادت پرور، علي، پاسداران حريم عشق حماة حدود المحبة: ج3، ص65.
[666] الشرقاوي، عبد الله، شرح حكم ابن عطاء الله السكندري: ص208.
[667] سعادت پرور، علي، نور هدايت نور الهداية: ج3، ص251.
[668] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج91، ص94 ـ 96، حديث12.
[669] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص23، حديث15.
[670] حسن زادة الآملي، حسن، رساله نور على نور در ذكر وذاكر ومذكور رسالة نور على نور في الذكر والذاكر والمذكور: ص31.
[671] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص687.
[672] ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة: ج10، ص127 ـ 129.
[673] الهمداني الدرودآبادي، حسين بن محمّد تقي، شرح الأسماء الحسنى: ص89.
[674] المصدر السابق: ص95.
[675] القاضي سعيد القمي، محمّد سعيد بن محمّد مفيد، شرح توحيد الصدوق: ج1، ص173.
[676] الحسيني، جواد، نيم نگاهي به شرح فرازهايي از دعاي عرفه نظرة مقتضبة إلى شرح مقاطع من دعاء عرفة، ميقات حج، رقم: 42، 1381 ﻫ.ش، ص185.
[677] المصدر السابق: ص185 ـ 186.
[678] الخميني، روح الله، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية: ص66.
[679] الفيض الكاشاني، محمّد بن شاه مرتضى، الحقائق في محاسن الأخلاق؛ قرة العيون في المعارف والحكم: ص182.
[680] النراقي، مهدي بن أبي ذر، جامع السعادات: ج3، ص145 ـ 146.
[681] الريشهري، محمّد، الطباطبائي نژاد، محمود، السيد الطبائي، روح الله، موسوعة الإمام الحسين× في الكتاب والسنة والتاريخ: ج9، ص223.
[682] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص349.
[683] الملكي التبريزي، جواد بن شفيع، رسالة لقاء الله: ص229 ـ 233.
[684] المصدر السابق: ص236.
[685] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص349.
[686] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج64، ص138.
[687] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج1، ص301.
[688] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج1، 200؛ المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج4، ص253، حديث6.
[689] مرواريد، حسنعلي، تنبيهات حول المبدأ والمعاد: ص86.
[690] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص349.
[691] الأعراف: آية176.
[692] الصدوق، محمّد بن علي بن بابويه، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ص176.
[693] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص352، حديث7.
[694] المصدر السابق: ص352 ـ 353، حديث8.
[695] المصدر السابق: ص353، حديث10.
[696] المصدر السابق: ص354، حديث11.
[697] الفيض الكاشاني، محمّد بن شاه مرتضى، الوافي: ج5، ص735 ـ 737.
[698] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص349.
[699] الأحزاب: آية33.
[700] الحج: آية30.
[701] الصحيفة السجادية: ص232.
[702] الطوسي، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجد: ج2، ص591.
[703] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص588، حديث26.
[704] كولبرغ، إيتان، كتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او مكتبة ابن طاووس وأحواله وآثاره: ص116 ـ 117.
[705] المصدر السابق: ص152 ـ 154.
[706] المصدر السابق: ص82 ـ 84.
[707] وفادار المرادي، محمّد، فهرست كتب خطي كتابخانه مركزي ومركز اسناد آستان قدس رضوي فهرس الكتب الخطية للمكتبة المركزية ومركز وثائق العتبة الرضوية المقدّسة: ج15، ص119.
[708] الكرباسجي، محمّد مهدي، بررسي متن، سند، شروح ونسخ خطي مصادر اوليه قسمت دوم دعاي عرفه سيد الشهداء× دراسة في إسناد القسم الثاني من دعاء عرفة لسيّد الشهداء× ونصّه وشروحه ومخطوطات مصادره الأولى: ص28.
[709] ترابي، حسين، پژوهشي درباره ذيل دعاي عرفه بحث حول ذيل دعاء عرفة، ميقات حج، رقم: 51، 1384 ﻫ.ش: ص54 ـ 55.
[710] الطوسي، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجد: ج1، ص163 ـ 164.
[711] ترابي، حسين، پژوهشي درباره ذيل دعاي عرفه بحث حول ذيل دعاء عرفة: ص55.
[712] الكرباسي، محمّد صادق محمّد، الصحيفة الحسينية الكاملة: ج2، ص9 ـ 10.
[713] المصدر السابق: ص10.
[714] الصافي الگلپايگاني، لطف الله، پرتوي از عظمت امام حسين× أشعة من عظمة الإمام الحسين×: ص166 ـ 167.
[715] ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج1، ص215 ـ 223.
[716] الريشهري، محمّد، الطباطبائي نژاد، محمود، السيد الطبائي، روح الله، موسوعة الإمام الحسين× في الكتاب والسنّة والتاريخ: ج2، ص191.
[717] المصدر السابق: ص191 ـ 192.
[718] المصدر السابق: ص192.
[719] المصدر السابق.
[720] ابن سعد، محمّد بن سعد، الـطبقات الكبرى: الطبقة الخامسة من الصحابة: ج1، ص414-415.
[721] المصدر السابق.
[722] الطوسي، محمّد بن الحسن، الخلاف: ج4، ص450.
[723] النجفي، محمّد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: ج32، ص82.
[724] ابن الهمام، كمال الدين محمّد بن عبد الواحد، فتح القدير: ج3، ص469.
[725] ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم، مجموع الفتاوى: ج33، ص8.
[726] ابن قيم الجوزية، محمّد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير العباد: ج5، ص227.
[727] المرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ج8، ص453.
[728] ابن قيم الجوزية، محمّد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين: ج3، ص31 ـ 34.
[729] الشوكاني، محمّد بن علي، نيل الأوطار: ج6، ص274.
[730] البقرة: آية228.
[731] البقرة: آية229.
[732] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج2، ص1099، حديث1472؛ ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج5، ص61، حديث2875.
[733] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج2، ص1095، حديث1471.
[734] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، مسند الإمام أحمد بن حنبل: ج4، ص215، الحديث2387.
[735] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج6، ص71، الحديث3؛ الحر العاملي، محمّد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج22، ص61، الحديث28022.
[736] مرتضى العاملي، جعفر، سيرة الحسين في الحديث والتاريخ: ج3، ص288.
[737] المصدر السابق: ص288 ـ 289.
[738] المصدر السابق: ص289 ـ 290.
[739] المصدر السابق: ص291.
[740] المصدر السابق: ص306 ـ 307.
[741] المصدر السابق: ص307 ـ 308.
[742] المصدر السابق: ص310.
[743] المصدر السابق: ص311 ـ 312.
[744] ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة: ج1، ص215 ـ 223.
[745] ابن بدرون، عبدالملك بن عبد الله، شرح قصيدة ابن عبدون: ص172 ـ 180.
[746] النويري، أحمد بن عبد الوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج6، ص180 ـ 185.
[747] ابن حجة، تقي الدين بن علي، ثمرات الأوراق: ص153 ـ 157.
[748] الشبراوي، عبد الله بن محمّد، الإتحاف بحب الأشراف: ص429 ـ 435.
[749] الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن: ج19، ص75.
[750] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم: ج6، ص153.
[751] الشعراء: آية214.
[752] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص321.
[753] المنقري، نصر بن مزاحم، وقعة صفين: ص118 ـ 119.
[754] المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر: ج3، ص11 ـ 12.
[755] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص557.
[756] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج7، ص314.
[757] الزبيري، الزبير بن بكار، الأخبار الموفقيات، ص593؛ ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة: ج6، ص31.
[758] ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4، ص1501.
[759] ابن الأثير، علي بن محمّد، أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج4، ص558.
[760] ابن الأثير، علي بن محمّد، الكامل في التاريخ: ج3، ص169؛ الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص424.
[761] ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية: ج8، ص179.
[762] الطبري، محمّد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن: ج19، ص74.
[763] مرتضى العاملي، جعفر، سيرة الحسين في الحديث والتاريخ: ج3، ص312.
[764] المصدر السابق: ص313.
[765] المصدر السابق: ص321.
[766] الأنبياء: آية104.
[767] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج4، ص2194 ـ 2195، حديث2860.
[768] اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص163.
[769] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص274.
[770] الجوهري البصري، أحمد بن عبد العزيز، السقيفة وفدك: ص62؛ ابن أبي الحديد، عبد الحميد ابن هبة الله، شرح نهج البلاغة: ج6، ص13.
[771] ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة: ج1، ص143 ـ 144.
[772] اليعقوبي، أحمد بن إسحاق، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص178.
[773] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج1، ص278.
[774] ابن سعد، محمّد بن سعد، الطبقات الكبرى: ج6، ص242؛ ابن الأثير، علي بن محمّد، أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج1، ص461؛ ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة في تمييز الصحابة: ج2، ص32.
[775] ابن الأثير، علي بن محمّد، أسد الغابة في معرفة الصحابة: ج1، ص461 ـ 462.
[776] المصدر السابق: ج1، ص461.
[777] ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة: ج1، ص145.
[778] ابن الجوزي، يوسف بن قزأوغلي، تذكرة الخواص: ص39.
[779] ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة: ج1، ص149.
[780] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص386؛ ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، المعارف: ص580.
[781] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص386.
[782] الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج5، ص171، حديث4985.
[783] البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج2، ص386.
[784] مرتضى العاملي، جعفر، سيرة الحسين في الحديث والتاريخ: ج3، ص326.
[785] المصدر السابق: ص327 ـ 328.
[786] المصدر السابق: ص328.
[787] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، ص637، حديث3723.
[788] ابن حنبل، أحمد بن محمّد، فضائل الصحابة: ج2، ص634، حديث1081.
[789] أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج1، ص64.
[790] ابن المغازلي، علي بن محمّد، مناقب أهل البيت^: ص157.
[791] ابن الجوزي، يوسف بن قزأوغلي، تذكرة الخواص: ص52.
[792] الگنجي، محمّد بن يوسف، كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب×: ص118 ـ 119.
[793] محب الدين الطبري، أحمد بن عبد الله، الرياض النضرة في مناقب العشرة: ج3، ص159.
[794] الحموي الجويني، إبراهيم بن محمّد، فرائد السمطين: ج1، ص99.
[795] ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمّد، الصواعق المحرقة: ج2، ص357 ـ 358.
[796] المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج13، ص147، حديث36462.
[797] المناوي، محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج3، ص46، حديث2704.
[798] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، تاريخ بغداد: ج11، ص204.
[799] المناوي، محمّد عبد الرؤوف بن تاج العارفين، فيض القدير شرح الجامع الصغير: ج3، ص46، حديث2704.
[800] القندوزي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج1، ص390.
[801] محب الدين الطبري، أحمد بن عبد الله، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص77.
[802] القاري، علي بن سلطان محمّد، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ج9، ص3940، حديث6096.
[803] الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، المتفق والمفترق: ج1، ص162؛ المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج11، ص605، حديث32924.
[804] الديلمي، شيرويه بن شهردار، الفردوس بمأثور الخطاب: ج1، ص370، حديث1491؛ المتقي الهندي، علي بن حسام الدين، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج11، ص614، حديث32973.
[805] أبو نعيم، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج1، ص64 ـ 65.
[806] الگنجي، محمّد بن يوسف، كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب ×: ص332.
[807] ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، علوم الحديث: ص84 ـ 85.
[808] الترمذي، محمّد بن عيسى، سنن الترمذي: ج5، 662، حديث3786؛ الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج3، ص66، حديث2680.
[809] الألباني، محمّد ناصرالدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: ج4، ص356 ـ 357.
[810] المصدر السابق: ص358.
[811] الطوسي، محمّد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار: ج1، ص3 ـ 4.
[812] ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن، علوم الحديث: ص82 ـ 83.
[813] ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله، شرح نهج البلاغة: ج10، ص127 ـ 129.
[814] الكتاني، سليمان، الإمام علي×؛ نبراس ومتراس: ص225 ـ 26.
[815] الزمر: آية17 ـ 18.
[816] النحل: آية89.
[817] الفخر الرازي، محمّد بن عمر، التفسير الكبير: ج11، ص307.
[818] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص69، حديث3؛ الحر العاملي، محمّد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج27، ص111، حديث33347.
[819] القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم: ج2، ص639، حديث927.
[820] الأنعام: آية164.
[821] الطحاوي، أحمد بن محمّد، شرح مشكل الآثار: ج5، ص114، حديث1864.
[822] المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج25، ص346.