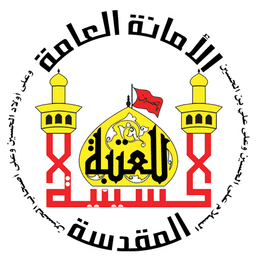مقدّمة قسم دائرة معارف الإمام الحسين×
كثيرة هي الحوادث التي شهدتها الإنسانيّة، في حراكها المستمرّ وصراعها الطويل، وقد أفلت كثير من هذه الحوادث من عقال التاريخ، فيما سجّلت مصنّفاته قسماً كبيراً منها أيضاً إلّا أنها لم تنل جميعها الأهميّة الكبيرة والمكانة المرموقة، بل قليلة هي الأحداث التي حظيت باهتمام البشريّة، فخلّدتها في الذاكرة، وظلت تعيش معها في مسيرتها المستمرّة.
والسرّ في ذلك هو الأثر المهمّ والتأثير الواضح لتلك الأحداث في بناء الحضارة الإنسانيّة، وترسيم ملامح المسيرة البشريّة بكلّ ما تحمله من أخلاق وقيم ومعتقدات، فوجد التاريخ الإنساني نفسه معنيّاً بتدوين مثل هذه الأحداث؛ ليحفظها للذاكرة البشريّة، ويخلّدها في وعي الإنسان وحركته الممتدّة.
وقد أوجدت بعض تلك الحوادث تحوّلاً كبيراً في تاريخ الإنسان وقيمه، فعلى الصعيد العلمي خلّد التاريخ تلك الكشوفات العلميّة التي كان لها الأثر الواضح في تطوّر البشريّة ورفاهها وتمدّنها.
وعلى الصعيد الإنساني ومنظومته القيمية والأخلاقيّة تبرز حوادث الصراع القائم بين الفضيلة والرذيلة والحقّ والباطل، بوصفها ثنائيّة رسمت ملامح سير المجتمع الإنساني منذ نشأته، هذا الصراع الذي امتازت فيه أُمم على أُخرى، وقادة على آخرين، ومثّل أحد طرفيه الأنبياء والمصلحون، حاملين مشعل الهداية وشعار تحرير الإنسان من الخنوع والخضوع والعبوديّة بكلّ صورها، في حين مثّل الطرف الآخر الطغاة والمفسدون، حاملين راية الشرّ سائرين بالمجتمعات نحو التخلّف والتيه والضلال.
وفي خضمّ هذا الصراع المحتدم، خلّد التاريخ نهضة أسهمت في تغيير حاضر الأُمّة ومستقبلها، وأثّرت كثيراً في وعي البشريّة وحركة الإنسان ووجوده بغضِّ النظر عن انتماءاته، ونقلت الإنسان إلى موقعٍ إستعاد فيه موقعه ومحوريّته في الوجود.
إنّها النهضة الحسينيّة التي رسمت ملامح مجتمعٍ جديد نفض عنه ركام ماضيه الغابر بكلّ حيثيّاته وهناته، ومثلت وراثة الحقّ الممتد مع بداية الخلق، منذ حركة نبي الله وأبي البشريّة آدم×، وصراعه مع الشيطان، ومروراً بأنبياء الله ورسله من نوحٍ وإبراهيم وموسى وعيسى^، ورسول الله‘، وأوصيّائه^، وهو الأمر الذي أشار إليه النص الوارد في زيارة وارث: «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله...»[1]، إذ لا من معنى للوراثة ـ هنا ـ إلّا وراثة خطّ الحقِّ في مواجهة الباطل بكلّ ما تعنيه وتحمله الكلمة من معنى.
أهداف النهضة الحسينيّة وأبعادها
لقد هدفت النهضة الحسينيّة إلى تحرير الإنسان المسلم من عبوديّة جديدة، وشركٍ مستحدَث، وهي العبوديّة للسّلطة الجائرة التي يكابد فيها الإنسان ظلماً، ويعيش في كنفها مضطهداً. هذه السلطة التي تهزأ بالإنسان حين تؤمّر عليه حاكماً لا أهليّة له في إدارة شؤون نفسه، فكيف بالأمّة؟! حاكماً تنمّ أفعاله عن تحلّلٍ سافرٍ وانحطاط ديني وأخلاقي، ويمثّل وجوده وتصدّيه لإمامة الأُمّة وقيادتها خطراً حقيقيّاً على إرادتها وقيمها التي رسمتها السماء، وضحّى من أجلها الأنبياء والأوصيّاء والمصلحون، وقد أشار الإمام الحسين× إلى مغبّة تسلّط مثل هؤلاء الأفراد على الأمّة، فقال×: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليتِ الأُمّة براعٍ مثل يزيد»[2].
لمّا رأى الإمام الحسين× أنّ الإنسان المسلم بدأ في ظلّ هذه السلطة يفقد قيمه الأخلاقيّة والدينيّة والعرفيّة، الأمر الذي أشار إليه في إحدى خطبه إذ قال: «... إنّ الدّنيا قد تغيّرت، وتنكّرت، وأدبر معروفها...، فلم يبقَ منها إلّا صبابة كصبابة الإناء، وخسيسُ عيشٍ كالمرعى الوبيل، ألا ترونَ أنَّ الحقّ لا يُعمل به، وأنَّ الباطل لا يتناهى عنه...»[3]، نهض بوجه هذه السلطة، فكانت ثورته×عبارة عن مواجهةٍ مصيريّة مع تيّار الانحراف الجارف للدين والمجتمع؛ لئلّا تضيع رسالة السماء وأهداف الأنبياء، وحركة الإنسان نحو التكامل.
لقد عاشت الأُمّة الإسلاميّة في تلك الحقبة بالذات انتكاسات كثيرة وعلى كافّة المستويات، نتيجة التجهيل والتضليل، ومنع تدوين الحديث، والدسّ والتزوير فيه، وشراء ذمم بعض أهل العلم، حتّى أدّى ذلك إلى خلق ثقافة جديدة، ومعاني أُخرى للمفاهيم الدينيّة تتناسب ومصالح السلطة، وشاعت العديد من المفاهيم المغلوطة والمؤطّرة بإطار الدِّين كمفهوم إطاعة السلطان الجائر، ومفهوم الحياد والاعتزال، وعقيدة الجبر، والتباس مفاهيم الثورة والفتنة، وغير ذلك.
لقد عاش الإنسان المسلم في ظلّ هذه السلطة معزولاً عن قيمه ومبادئه كافّة ودينه الحقّ، تغذّيه سلطة الباطل بما تشاء، فتوسّع مفهوم العزلة ليصل إلى العزلة عن الدِّين ونصرته، وصار كلّ خروجٍ على الحاكم شقّاً للصّف، وتمزيقاً للأمّة، وفتنة تحلّ بويلاتها على المسلمين، حتّى وإنْ كان خروجاً على الباطل، ونصرةً للدين.
كانت النهضة الحسينيّة أمراً لا بدَّ منه؛ لإعادة الأمة إلى مسارها الصحّيح، فكان شعار الإصلاح السمة الأساسيّة لهذه النهضة، وهو ما صدح به الإمام الحسين×، حيث قال×: «... وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أُمّة جدّي محمد‘، أريد أنْ آمرَ بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي محمد‘...»[4]، فنهض من أجل هذه الغاية، وضحّى×بنفسه، وأهل بيته وأصحابه، بعد أنْ تفرّقت الأُمّة وتخاذلت عن نصرته.
لقد رسّخت النهضة الحسينيّة المبادئ والقيم الإنسانيّة والأخلاقيّة والدينيّة في الأُمّة، فصارت الأُمّة تستمدّ منها منهاجاً لحاضرها ومستقبلها في مواجهة الباطل على مرّ العصور.
نعم، صُدِمت الأُمّة بادئ الأمر باستشهاد الحسين×، وأحسّت بلوعة تلك المأساة، إلّا أنَّ حالة الحزن سرعان ما توقّدت واستحالت إلى غضبٍ في نفوس الأمّة، وإحساس بواقعها المرّ، والتراجع الذي تعيشه على كافّة الأصعدة، فعلتْ الأصوات الرافضة للظلم والانحراف، ولاحت ملامح التحرّك نحو التغيير، وقامت الثورات على الظالمين، ولم يهدأ بال سلطانٍ منذ نهضة الإمام الحسين×.
لم يقتصر تأثير النهضة الحسينيّة على زمان أو مكان، بل توارثتها الأُمم جيلاً بعد جيل، يقتبسون من مفاهيمها ومضامينها الثوريّة السامية حتّى مثّلت على مرّ التاريخ خطراً على سلاطين الجور وانحرافاتهم؛ لقوّة تأثيرها وسرعة انجذاب النفوس إلى المبادئ السامية التي رسّختها، الأمر الذي واجهته السلطات الظالمة على مرّ التاريخ، بكلّ ما أُتيحت لها من وسائل وأساليب، فمنعت من إحياء ذكرى عاشوراء وزيارة الحسين×، وقامت بتهديم قبره الشريف، وعملت على طمس ذكره من خلال تجنيد الأقلام المأجورة لإثارة الشبهات وتزييف الحقائق، وما إلى ذلك، إلّا أنّها لم تتمكن ـ رغم ذلك كلّه ـ من إخماد جذوة النهضة وإطفاء نورها، بل زادت في توقّدها وانجذاب الأمّة، بل الإنسانيّة إلىها.
لقد شغلت نهضة الإمام الحسين× موقعاً مهمّاً وراسخاً في وعي البشريّة، لمبادئها الإنسانيّة التي لم تتلبّس بلبوس المذهبيّة ولا القوميّة ولا الدينيّة ولا العرقيّة، فكانت: نهضة علّمت الإنسانيّة درساً في التفاني والإيثار، فاستطاعت ـ وهي مضرّجة بالدم ـ أنْ تزيل عروش الطغاة والمستكبرين وأهل الباطل؛ لتعلي الحقّ، وترفع من قيمة الإنسان، وترسخ القيم الإنسانيّة والدينيّة..
ولكي تصل أهداف النهضة الحسينيّة وأبعادها المختلفة إلى المتعطّشين لها، كان لابدّ أن تنقل هذه الأهداف عبر قنوات نقيّة، وأقلام نزيهة صادقة، فمن هنا تبرز في هذا المضمار ضرورة الكتابة والتأليف في النهضة الحسينيّة، من أجل الكشف عن وجهها الناصع وإزالة غبار المشكّكين، وأباطيل المبطلين عنها.
النهضة الحسينيّة بين ضرورة التدوين وتهمة التحريض
يواجه التأليف في النهضة الحسينيّة وأحداثها ونتائجها ومعطيّاتها إشكالاً، مفاده: أنَّ هذا العمل يستدعي التحقيق في التراث الروائي والتاريخي، فيؤدّي إلى إشاعة روح الحقد والكراهية بين أبناء الأُمّة، وتأجيج روح الضغينة والبغض بين أطيافها وطوائفها؛ الأمر الذي له سلبيّاته المنافية لأهداف تلك النهضة، وعليه؛ فمن الأفضل الاقتصار على الأُمور الظاهريّة في التعرّف على النهضة الحسينيّة، دون الغور في أعماقها، واستنطاق الموروث لمعرفة دقائقها.
وهذا الإشكال لا يختصّ بالنهضة الحسينيّة، بل يعمّ التراث الإسلامي الروائي والتاريخي وغيره، حتّى بالغ بعضٌ في الأمر حين دعا إلى القطيعة مع هذا الموروث، وتركه بين الرفوف كلوحات أثريّة دون أن يكون لها أثر في حركة عجلة الحاضر والمستقبل.
إلّا أنّ هذا الإشكال لا قيمة ولا نصيب له من الواقعيّة، إذ متى كان تراث الأُمّة عائقاً في طريق تقدّمها، بل الأمر على العكس من ذلك، فإنَّ الأُمم تستدعي تراثها ونهضاتها وتاريخها؛ لتقف على معالجات قضايا الحاضر بتجارب الماضي وحلوله، مع إضافات تناسب زمانها الذي تعيش فيه.
إنَّ أيَّ أُمّة تعلن القطيعة مع تراثها، فهي تحكم على نفسها بالموت، وتفقد هويّتها الحضاريّة، لتلتحق بركب حضارة أُخرى لاغيةً خصوصيّاتها، مندكّة في خصوصيّات الآخرين وباستنساخ أعمى، من دون الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة وخصوصيّات تلك الأُمم والمجتمعات.
إنَّ عمليّة تصحيح التراث وتنقيحه وتقويمه، تهدف إلى إعطاء التراث القيمة الحقيقيّة والتأثير الأفضل، والإفصاح عن الإرث التاريخي والحضاري للأُمّة؛ لتقف على أهمّ المحطّات في تاريخ نهوضها الحضاري، واستلزام الفرقة والتشتّت لا يرجع إلى التراث نفسه، بل إلى القرّاءة المغلوطة للدين والتراث، والآيديولوجيّة المنحرفة القائمة على محاولات تجيير النصوص لصالح أفكارٍ مسبقة، أو شخصيّات محدّدة، أو إضفاء قدسيّة وعظمة لحدثٍ دون حدث، وغير ذلك من الأُمور.
من هنا؛ لا بدّ من الأدوات والأساليب المنهجيّة السليمة في دراسة التراث وتحليله؛ كي تعطي تلك العمليّة ثمارها الإيجابية بعيداً عن التطفّل أو التعصّب.
هذا فيما يتعلّق بالتراث بشكلٍ عام، أمّا ما يخصّ النهضة الحسينيّة؛ فإنَّ استذكار بعض حوادثها وقرّاءتها لم يكن في زمن من الأزمان سبباً للشحناء والبغضاء، بل الأمر على العكس من ذلك، فالأُمّة مجمعة على أحقيّة الإمام الحسين× ومظلوميّته، وفسق أعدائه وظلمهم، وأحقيّة النهضة ومشروعيّتها وعظمة أهدافها، وما تركته من آثار على مسيرة الأُمّة الإسلاميّة، بل حتى على الصعيد الإنساني، من هنا كتب العديد من الباحثين والشعراء وأصحاب القلم من غير المسلمين في واقعة الطفّ، بل تمنّى بعضهم أن يكون لهم شخص كالحسين×؛ لينشروا أديانهم من خلال نهضته.
إنّنا إذا ما حقّقنا عن تلك الفئات التي ترى في النهضة الحسينيّة مثاراً للفتنة والبغضاء، نجد أنّها من تلك المدرسة نفسها التي واجهها الإمام الحسين× في نهضته، وذلك التوجه الذي يُبرّر للسلطان أفعاله، ويضفي عليها نوعاً من القداسة من خلال تطويع النصوص وخلط المفاهيم، ولا تجد فيما آلت إليه أوضاع المسلمين آنذاك من خطورة، فمن الطبيعي أن تثير النهضة الحسينيّة حفيظة هؤلاء؛ لأنّها نهضة جاءت لدحض هذا الفكر المغلّف بالإطار المزّيّف.
النهضة الحسينيّة، ليست مشروعاً ضدّ أحد، إلّا اليزيديين فكراً وممارسة على مرّ التاريخ، كما أن الفرقة والتشتّت الذي أصاب الأُمّة كان جرّاء سياسات الفئة الضالّة التي حرّفت الدِّين، وعملت على حرف المسيرة، واتخاذ عباد الله خولاً وأموالهم دولاً، بمساعدة وعّاظ السلاطين ممّن حاول أن يقرأ التاريخ والحديث وكلّ ما يرتبط بالتراث الإسلامي قرّاءة تطويعيّة مع معتقداته، فإنْ وجد فيه ما يناسب توجّهه بادر لقبوله وإعلاء شأنه، وإنْ تعارض مع فكره طرحه، حتّى وإنْ كان صحيحاً، بل كفّر كلّ من يأخذ به ويقبله.
إنَّ استغلال النهضة الحسينيّة لإثارة النعرات وتطويع النصوص لصالح فكرة مسبقةٍ أو فهم مغلوط، ممّا ترفضه قيم النهضة الحسينيّة؛ وأهدافها التي من أهمها الإصلاح في أُمّة محمد‘، دون الإفساد والتفريق.
من هنا؛ فإنَّ الخوض في التراث الإسلامي المعرفي لاستنطاقه فيما يخصّ جميع الجوانب المعرفيّة والحركيّة بما فيها النهضة الحسينيّة، يعدُّ من أكمل الأعمال التي تقوم بها أُمّة ما إزاء تاريخها وماضيها.
ولا يعني ذلك أنّ هذه القراءة تدفعنا للعيش أجساداً في الزمن الحاضر، وأفكاراً تعيش الماضي، وتسقطه بكلّ محتواه على الحاضر، فإنّ هذا الأمر يأباهُ العقل السليم، فكلّ إنسانٍ ابن حاضره، يتعايش معه، ويجد حلولاً تناسب مشكلاته، بل الهدف هو استلهام القيم الإنسانيّة والدينيّة التي لا تتبدّل بتبدّل الأزمنة، ومن ثمّ بناء الحاضر والتخطيط للمستقبل.
إنّ التركيز على تلك الحقبة وأحداثها وإن كان أمراً مهمّاً باعتباره توثيقاً وقراءة مهمّة لحقبة من حقب الأُمّة الإسلاميّة، إلّا أنّ الهدف هو استكشاف واستخلاص المعاني والعبر والقيم العليا التي يمكن أنْ تكون مناراً للأُمّة في حاضرها ومستقبلها.
النهضة الحسينيّة بين فردية التدوين والتأليف، وضرورة العمل الموسوعي
انطلاقاً من أهمية هذه النهضة، وتأثيرها على المستوى الإسلامي والإنساني ظهرت مصنّفات وأبحاث وقراءات متعدّدة، وبُذلت جهود كثيرة في سبيل سرد أحداثها وتحليلها، وبيان وظيفتها الإصلاحيّة ودورها في بناء الإنسان والمجتمع، وإحياء القيم الإنسانيّة والأخلاقيّة فيه، وإظهار كيفيّة قدرتها وتأثيرها في تحرير إرادة الأمة وخلق روح الرفض للظلم وإباء الظيم، الأمر الذي تجلى في الثورات التي استلهمت قوّتها من هذه النهضة، كلّ ذلك من خلال قراءة دقيقة في التراث الذي نقل هذه النهضة المباركة، ووثّق تفاصيلها، وحيثيّاتها بدءاً من إرهاصاتها الأُولى، ووصولاً إلى أحداثها ونتائجها.
وهنا يجب أن نلحظ أمراً مهمّاً، وهو أنَّ عمليّة التدوين والتوثيق والحفظ كانت في أغلب الأحيان عمليّة فرديّة، فإنَّ أمّهات المصادر من موسوعات تاريخيّة كتاريخ اليعقوبي، والطبري، وأنساب الأشراف، ومقاتل الطالبييّن، وتاريخ ابن كثير وغيرها، جهود فرديّة قام بها أصحابها من أهل الاختصاص والمهتمّين بهذا الشأن، وهي على أهمّيتها تبقى خاضعة أحياناً لنظرة المؤلّف المسبقة وخلفيّته الفكريّة والسياسيّة واهتماماته، مضافاً إلى التأثّر بالفضاء المعرفي المغلق الذي تتحكّم به السلطات المتعاقبة المنحازة لطرفٍ على حساب آخر في سبيل خدمة سلطانها، وأدلّ دليل على ذلك ما عاناه الطبري من حنابلة بغداد، حتّى أنّه اعتزل في بيته، ومات غريباً فيه، كما تشير إلى ذلك بعض المصادر.
ومع ذلك، كانت هذه الجهود التأسيسيّة ذات قيمة عالية، فهي الأعمال الأُولى التي رسمت خارطة طريق للمصنّفات اللاحقة.
ولا يخرج تدوين وتوثيق النهضة الحسينيّة عن هذا الفضاء، فقد كانت المصنّفات قائمة على الجهد الفردي للرواة بتتبّع الأحداث والتثبّت منها وتوثيقها؛ لذا فإنَّ كثيراً من خبايا الطفّ خفيت عن هؤلاء، أو تناثرت بين المصنّفات التاريخيّة لهذا الراوي أو ذاك.
وقد ظهرت خلال الحقبة الأُولى العديد من المقاتل التي كان لها الفضل الكبير في التأسيس لعمليّة التدوين والتأليف في النهضة الحسينيّة وما يدور في فلكها، منها: تسمية من قتل مع الحسين× للرسّان، ومقتل الأصبغ بن نباتة، ومقتل جابر بن يزيد الجعفي، ومقتل عمّار الدهني، ومقتل أبي مخنف، وغيرها من المقاتل، وهي مقاتل لم يصل منها إلّا ما نقله المؤرّخون عنهم. وتتالت المحاولات والتصانيف في النهضة الحسينيّة في كلّ القرون، وحتّى زماننا الحاضر، وهي امتداد لما سبقها من المصنّفات الأوّليّة التأسيسيّة، مع إضافات من هنا وهناك، كما أنّها لم تخرج عن طابع الفرديّة المتّسم بعدم الشمول، فكلّ مصنّفٍ ناظر إلى زاوية معيّنة من زوايا النهضة الحسينيّة، ليشبعها دراسةً وتحليلاً.
ومع الحاجة الملحّة في زماننا الحاضر للاستيعاب والتحليل، مع السهولة في الوصول إلى المطلوب، ومراعاة الضوابط العلميّة القائمة على أُسس منهجيّة، وضمن آليات عملٍ منظّمةٍ يشارك فيها عدد كبير من الباحثين لإنجاز المشاريع الاستراتيجيّة، شَخصتْ في هذا المجال أهمّية الموسوعات ودوائر المعارف في إغناء الكتابة في النهضة الحسينيّة.
أهمّية الموسوعات ودوائر المعارف
تمثّل دوائر المعارف أهمّ المشاريع العلميّة والمعرفيّة لأيّ علم ومعرفةٍ يراد تداولها والإلمام بها وإيصالها بأسرع وقت وأقل جهد، فهي عبارة عن مرجع يضمّ معلومات يقلّ فيها السرد والتطويل وتزداد فيها الفكرة والتصوير. وغالباً ما يقوم بها عدد من الكتّاب ممّا يسهم في تنويع البحوث واستيعاب المعلومات، وغياب النزعة الفرديّة في التعامل مع المعطيّات وتحليلها.
وتحتلّ الموسوعات أهمّية كبيرة في الميدان المعرفي؛ فمن خلالها يمكن إعطاء معلومات أساسيّة، وحقائق أوّليّة حول مواضيع مختلفة، وتساعد في تقديم الإجابات عن كثيرٍ من الأسئلة والاستفسارات المرجعيّة، وتعدّ مصدراً لإرشاد القارئ الساعي للاستزادة من خلال ما توفّره من قائمة بمصادر المعلومات المطروقة.
وهي على قسمين:
الموسوعات العامّة: وهي الموسوعات التي تهتمّ بالبحث في مواضيع عامّة، وفنون وعلوم إنسانيّة متعدّدة.
الموسوعات الخاصّة: وهي الموسوعات التي تهتمّ بموضوعات محدّدة ومجالات خاصّة.
وهنالك عدّة طرق معتمدة لترتيب المعلومات داخل الموسوعات، أهمّها الترتيب الهجائي الذي يمكن من خلاله الرجوع إلى المواضيع بأقلّ جهد، وأقصر وقت، والترتيب الموضوعي، وهو الأُسلوب المتّبع قديماً في دوائر المعارف والموسوعات، وبموجبه يتمّ تقسيم المعرفة البشريّة إلى قطاعات مختلفة في العلوم والفنون، ويتمّ ترتيبها تبعاً لأهميتها.
وللموسوعات مميّزات عدّة نذكر أهمّها عند التعرّض لضرورة دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّة وأهمّيتها.
الموسوعات الحسينيّة
لمّا كانت لدوائر المعارف والموسوعات أهمّية كبيرة، بادر المهتمّون بالشأن الحسيني إلى إصدار موسوعات ودوائر معارف، في مختلف جوانب النهضة الحسينيّة، وما يدور في فلكها، اختصّ بعضها بجانب خاصّ ومعيّن كأعلام الطفّ، أو أصحاب الإمام الحسين×، أو المقاتل بالتحديد، كما ظهرت موسوعات تهتمّ بالشعراء والخطباء في الشأن الحسيني، وشمل بعضها الآخر كلّ ما يرتبط بالنهضة الحسينيّة، وأهمّ تلك الموسوعات ودوائر المعارف، هي:
1ـ دائرة المعارف الحسينيّة، الصادرة عن المركز الحسيني للدراسات، لمؤلفها الشيخ الدكتور محمد صادق محمد الكرباسي وهي موسوعة عامّة شملت جميع الموضوعات، من أعلام وشعر، وشعراء وخطباء، وتاريخ المراقد، والحسين× والتشريع الإسلامي، وغير ذلك من الموضوعات، وقد صدر منها ما يقارب المائة مجلّد، وهي ـ كما يقول القائمون عليها ـ تضمّ نحواً من تسعمائة مجلّد، إعتمدت فيها الطريقة الموضوعية، وأسلوب الكتابة فيها يقوم على البحوث التفصيليّة المطوّلة في الغالب.
2ـ تاريخ إمام حسين× (موسوعة الإمام الحسين×)، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الإيرانيّة والمتكوّنة من 24 مجلّداً، وهي من الموسوعات المهمّة في مجال جمع وتوثيق كلّ ما يتّصل بالنهضة الحسينيّة، من وقائع وشخصيّات وأعلام وأماكن، وغير ذلك من الموضوعات المتّصلة بالنهضة الحسينيّة، وهي مقسّمة حسب الموضوعات، اتُّبع فيها تجميع النصوص التاريخيّة والحديثيّة، دون التصرّف فيها أو صياغتها على شكل مقالات أو غير ذلك،كما اِعتمِدت فيها جميع المصادر بغض النظر عن إعتبارها وعدمه. عمل عليها مجموعة من الباحثات، وأشرف عليها بعض كبار المحقّقين.
3ـ موسوعة الإمام الحسين× في الكتاب والسنّة والتاريخ، لمؤلّفها الشيخ محمد الري شهري وجملة من الباحثين، والمتكوّنة من عشرة مجلّدات، إضافة لمجلّدين في الفهارس، وهي من الموسوعات المهمّة في ميدان المعرفة الحسينيّة، وهي مقسّمة حسب الموضوعات، وتعتمد على تجميع النصوص بما يتناسب مع الموضوعات المعدّة، مع إيضاحات وتحليلات، كما اِشتملت على دراسات لبعض القضايا المهمة المتعلقة بحادثة عاشوراء، وقد حدّد القائمون عليها 33 مصدراً معتبراً وصالحاً للأخذ عنه، مقتصرين فيها على الحقبة الممتدّة من بداية التأليف إلى القرن التاسع الهجري، وقد اشتملت هذه الموسوعة على فهارس ذات قيمة عالية في الدلالة والبحث في النهضة الحسينيّة.
4ـ موسوعة مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، لعدّة باحثين، وهم نجم الدِّين الطبسي، ومحمد جواد الطبسي، ومحمد جعفر الطبسي، وعلي الشاوي، وعزّت الله المولائي، وهي في خمسة مجلّدات، تتحدّت عن النهضة الحسينيّة وفق التسلسل التاريخي، فتبدأ من المدينة المنوّرة وتنتهي بها.
5ـ موسوعة سيرة الإمام الحسين× في الحديث والتاريخ، وهي موسوعة ضخمة تتكوّن من أربعة وعشرين جزءاً، للسيد جعفر مرتضى العاملي، تناولت كافّة مراحل حياة الإمام الحسين× وسيرته وجهاده من خلال قراءة تحليليّة في الأحاديث والتاريخ.
6ـ موسوعة الثورة الحسينيّة، للشيخ محمد نعمة السماوي، والمؤلّفة من تسعة أجزاء، وقد تضمّنت هذه الموسوعة دراسات وتحليلات عن النهضة الحسينيّة وأهدافها وظروفها ووقائعها ونتائجها، وأحاديث عن أنصارها ومناوئيها، وبحوثاً في تاريخ الإسلام والمسلمين ومجتمعاتهم في ظل الخلاف والاختلاف، وقد اتّبع المؤلّف الأُسلوب الموضوعي في ترتيب عناوينها، مبتدئاً جهده بالبحث عن الفهم الصحيح للإسلام الذي يتسنّى من فهم الثورة الحسينيّة وأبعادها كافّة.
7 ـ موسوعة الإمام الحسين×، للسيد علي عاشور الذي ركّز فيها على معرفة عبادة الإمام الحسين×، ومكارم أخلاقه، مبتدئاً ذلك بالتعريف بأهل البيت^، ثمّ سار في منهجه حسب الترتيب الموضوعي للعناوين، فذكر الأدعية، والأعمال العباديّة الواردة عن الإمام الحسين× كافّة، وختمها بمسند كبير تضمّن كلمات الإمام× من بداية حياته، وحتى شهادته، وقد تكوّنت هذه الموسوعة من عشرين جزءاً.
8ـ موسوعة مقتل الإمام الحسين×، من إعداد محمد بن عيسى آل مكباس البحراني، وتنظيم جعفر الوائلي، تضمّ أُمّهات المصادر والمقاتل التي كتبت عن المقتل الشريف من القرن الأوّل إلى القرن العاشر الهجري، مرتّبة بحسب الفترة الزمنيّة.
9ـ موسوعة كربلاء، هي موسوعة تتألّف من جزئين، لمؤلّفها لبيب بيضون، يتكوّن الجزء الأوّل منها من خمسة أبواب، تضمّنت معلومات عن مصادر الموسوعة، وأنساب آل أبي طالب، وفضائل أهل البيت^، ثمّ لمحة عن حكم معاوية، وصلح الإمام الحسن×، ثمّ ولاية يزيد ونهضة الإمام الحسين× ومسيرته نحو كربلاء.
ويتكوّن الجزء الثاني من أربعة أبواب، تضمّنت أحداث معركة كربلاء حتّى استشهاد الإمام الحسين×، وأحداث ما بعد المعركة من حمل الرؤوس وتسيير سبايا أهل البيت^ إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة، ثمّ نحو الشام. وينتهي هذا الجزء بذكر بعض أعمال يزيد بعد معركة كربلاء.
10 ـ موسوعة عاشوراء، موسوعة صغيرة بمجلّد يناهز الستمائة صفحة، لمؤلّفها الشيخ جواد محدّثي، صادرة عن دار الرسول الأكرم‘ والمحجّة البيضاء.
وهي من الموسوعات الألفبائيّة التي تعتمد في تسلسل عناوينها الحروف الهجائيّة، والتي تضمّ بين طيّاتها المفاهيم، والأماكن، والأعلام، والأُسر، والقبائل، والحوادث، والوقائع بصورة مختصرة.
11 ـ موسوعة أدب الطفّ أو شعراء الحسين×، وهي موسوعة تتناول الشعر الحسيني من القرن الأوّل الهجري، وحتى القرن الرابع عشر، تتكوّن من عشرة أجزاء، لمؤلّفها السيّد جواد شبّر.
12 ـ موسوعة مقتل سيّد الشهداء×، وهي موسوعة مشتملة على تاريخ حياة الإمام الحسين× من ولادته إلى شهادته، صادرة عن مركز الخيمة للدراسات الاستراتيجيّة.
13- موسوعة المقاتل الحسينيّة، الصادرة عن مؤسّسة وارث الأنبياء × للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة، وهي موسوعة تحقيقيّة شاملة لكلّ ما كتب حول نهضة الإمام الحسين× وقصّة مقتله، ومقتل أهل بيته، وأصحابه، وسبي عياله، وما سبقها ورافقها من أحداث، وتلاها من تداعيات، تمّ فيها جمع المقاتل وتحقيقها تحقيقاً علميّاً من خلال الرجوع إلى مخطوطاتها ومقابلتها، مع ضبط المتون وتصحيحها وتخريج المصادر والتعليق على بعض المطالب والترجمة للشخصيّات والتعريف بالمناطق والمدن الواردّة فيها، وبيان المعاني اللغويّة لبعض الكلمات والمفردات، وغير ذلك، بأسلوب علمي رصين .
تشمل هذه الموسوعة جميع المقاتل الحسينيّة من القرن
الأوّل إلى القرن الرابع
عشر، إلّا ما تعذّر الوصول إليه منها لفقده.
14 ـ الموسوعة العلميّة من كلمات الإمام الحسين×، الصادرة عن مؤسّسة وارث الأنبياء× للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة، وهي موسوعة علميّة تخصّصيّة، مستخرجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة.
وستصدر عن مؤسّسة وارث الأنبياء بالإضافة إلى هذه الموسوعات موسوعة حسينيّة أُخرى قيّمة، وهي: موسوعة ردّ الشبهات، وهي موسوعة علميّة تعنى برصد الشبهات المثارة حول لإمام الحسين× ونهضته المباركة بجميع أبعادها العقدية والعلميّة والفكريّة وغيرها، ومن ثمّ الإجابة الرصينة والواضحة عليها.
دائرة معارف الإمام الحسين × الألفبائيّة
رغم المحاولات الجادّة في هذا النوع من العمل في مجال التراث الحسيني؛ ووجود تلك الموسوعات ودوائر المعارف، والتي هي جهود عظيمة ونتاجات قيّمة، وإكمالاً لهذا المشوار الطويل من التدوين التاريخي المختصّ بالقضيّة الحسينيّة باشرت مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة بالعمل على دائرة معارف حسينية ألفبائيّة تعمل على كل ما يرتبط بالنهضة الحسينيّة، وتعتمد الضوابط والمعايير المستخدمة في الموسوعات ودوائر المعارف.
ضرورة دائرة معارف الإمام الحسين × الألفبائيّة وأهمّيتها
تكمن أهمّية هذا المشروع في جهتين:
الجهة الأُولى: أهمّية الموسوعات ودوائر المعارف في حدّ ذاتها، باعتبارها مؤلّفات تشتمل على معلومات عامّة حول العلوم والمعارف الإنسانيّة عامّة، أو في موضوع وعلم خاص، وتتميّز بما يلي:
1ـ الشمول والاستيعاب لكل جوانب موضوعاتها، ما يجعلها مصدراً مهمّاً للمعلومات في تلك الموضوعات.
2ـ تأمين سهولة الوصول إلى المعلومة؛ لاعتمادها الترتيب الهجائي في مفاصل البحث، ومفرداته ومداخله.
3ـ غزارة المعلومات وتنوّعها؛ لاعتمادها على كتّاب متعدّدين، وفي اختصاصات مختلفة.
4ـ العمق والتحقيق؛ لتركيز كل مقالة من مقالاتها على جزئيّة معيّنة، فتحاول بحث كلّ حيثيّاتها وأطرافها، مع خضوع مقالاتها للتحكيم العلمي من قبل هيأة علميّة من ذوي الاختصاص، فتعدّ هذه الدوائر من المصادر المهمّة والرصينة في مجالها.
5ـ مخاطبة جميع المستويات العلميّة والثقافيّة، فيمكن للمتخصّصين والباحثين الإفادة منها، كما يمكن ذلك للقرّاء والمثقّفين الذين يبحثون عن معلومة جاهزة مختصرة مبلورة.
6ـ المساهمة في إرشاد الباحث أو القارئ إلى معلومات إضافيّة ـ إن أراد الاستزادة منها في المجال المبحوث ـ بواسطة الببليوغرافيات وقائمة المصادر التي تقدّمها في نهاية مقالاتها.
الجهة الثانية: أهميّة موضوع النهضة الحسينيّة بشكل خاص، والتي تكمن في أهمية التراث الحسيني الثرّ، الذي يعدّ منهج حياة أمثل للبشريّة في سيرها التكاملي على طريق الهداية والصلاح، المتمثّل في خلفيّات ثورة الإمام الحسين× وأسبابها وأهدافها وآثارها، وما حملته من مفاهيم إنسانيّة وإسلاميّة، وأعطته من دروس وعبر، ورسمته من منهج للحريّة والإباء، واشتملت عليه مواقفها وشعاراتها وشعائرها من فقه وفكر وأخلاق سامية ومفاهيم عظيمة، ومعارف قيّمة، أهّلتها لأن تكون السبب في حفظ الإسلام وضمان بقائه واستمراريّته، وأن تصبح مدرسة عظيمة للأجيال، ومَعيناً لا ينضب، رغم محاولات الحكّام الجائرين وكيد الكائدين وظلم الظالمين.
وكل ذلك يدعو وبألحاح شديد وضرورة ملحة إلى إحياء التراث الحسيني، وتجديده عبر إبرازه للقارئ والمتلقّي بصورة يسهل عليه أخذه والإفادة منه، من خلال الطرق والأساليب الحديثة في العرض والبيان التي منها دوائر المعارف والموسوعات التي ذكرنا خصائصها ومميّزاتها آنفاً، ويأتي هذا المشروع لتحقيق هذا الغرض؛ إذ يهدف إلى وضع دائرة معارف شاملة وجامعة لكلّ ما يتعلّق بالإمام الحسين× ونهضته العظيمة؛ لتكون من أهمّ وأوسع المصادر في المجال التاريخي والعلمي والعقدي والفكري، وغير ذلك من المعارف الحسينيّة.
خصائص دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّة
تختلف هذه الموسوعة عمّا سبقها من الموسوعات والدراسات الحسينيّة من عدّة جهات، أهمّها:
أ. تغطيتها لمساحات كثيرة لم يسبق تغطيتها في الموسوعات الأُخرى ـ حسب استقرائنا ـ إذ تشمل كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× وثورته العظيمة من مفاهيم وأحكام وأماكن وأعلام، وغير ذلك، وتحتوي على بحوث تاريخيّة وجغرافيّة وفقهيّة وعقديّة وأخلاقيّة، وغير ذلك من العلوم والفنون حسب المدخل أو المصطلح المبحوث، بل قد يتنوّع البحث في المدخل الواحد لتنوّع جهات البحث فيه، كالمداخل المرتبطة بالشعائر الحسينيّة؛ فإنّها قد تبحث من الجهة الفقهيّة والتاريخية، كما أنّ للبعد الفكري والعقدي أهمّية كبيرة فيها.
هذا مضافاً إلى التوسّع في تحليل الوقائع التاريخيّة والبحث عن عللها وعواملها وآثارها وتداعياتها.
ب. عدم الخضوع لسليقة معيّنة وذوق خاصّ؛ لكونها تضمّ بين دفّتيها مقالات وأبحاث لمختلف العلماء والباحثين، وفي مختلف الاختصاصات، بخلاف الموسوعات التي يتصدّى لتأليفها شخص واحد، أو تتمّ تحت إشراف شخص معيّن ـ كما هو الحال في أغلب الموسوعات في هذا المجال حسب اطّلاعنا ـ فإنّها تتأثّر بطبيعة الحال بطريقته ومنهجه وذوقه الخاصّ.
ج. اعتمادها الترتيب الألفبائي الذي ذكرنا خصائصه، في حين أنّ أغلب الموسوعات الحسينيّة التي صدرت اعتمدت المنهج الموضوعي المحوري.
د. التوسّع في جمع المعلومات وتحليل الوقائع التاريخيّة والبحث عن عللها والعوامل المؤثّرة والآثار والتداعيات المترتّبة عليها.
تعريف دائرة معارف الإمام الحسين×
دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائية، موسوعة متخصّصة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة، وكلّ ما يرتبط بها، تعتمد أُسلوب دوائر المعارف، وطريقة المداخل والمفردات في كتابة بحوثها، وليس النظام الموضوعي القائم على توزيع البحوث والمطالب وفق الموضوعات والمباحث ذات الوحدة الموضوعيّة، كما أنّها تتبع التسلسل الألفبائي في تسلسل المداخل وترتيبها.
اسم دائرة معارف الإمام الحسين×
وقع الاختيار على أن يكون الاسم: «دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّة»، وأُضيفت كلمة الألفبائيّة إلى الاسم تأكيداً على النظام المتّبع فيها ـ أي نظام المداخل والتسلسل الهجائي الألفبائي ـ وكذا تمييزاً لها عن غيرها.
الأهداف
تتمثّل الأهداف من كتابة دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّة بما يأتي:
أ. إيصالُ أكبر قدرٍ من المعلومات عن النهضة الحسينيّة بعبارات مختصرة، وأسلوب موسوعي حديث، يُسهّل على القارئ والباحث الوصول إلى المعلومة بأسرع وقت وأقلّ جهد.
ب. أنْ تكون مرجعاً للباحثين المتخصّصين والطبقات المثقّفة، توصلهم إلى المعلومات وتهديهم إلى المصادر.
المخاطب
المخاطب في دائرة معارف الإمام الحسين× جميع طلّاب العلم وروّاد الفكر من باحثين ومحقّقين وخطباء وأكاديميين ومثقّفين، وفي جميع الاختصاصات؛ لأنّها تشتمل على موضوعات متعدّدة، تاريخيّة وعقديّة وفقهيّة وأخلاقيّة وغيرها، وهو ما يفرض لغة واضحة ورصينة في الوقت نفسه.
نظام كتابة دائرة المعارف
هناك ثلاث طرائق في كتابة الموسوعات:
أ. الألفبائيّة: وهو ما عليه أكثر دوائر المعارف والموسوعات العامّة والعالميّة كالموسوعة البريطانيّة، والموسوعة الإسلاميّة الكبرى، والموسوعة السياسيّة للكيالي، والموسوعة الفقهيّة الكويتية، وموسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت^، ودائرة المعارف الشيعيّة العامّة، وغيرها، فإنّها قد اعتمدت في ترتيب المفردات والمداخل والمصطلحات النظام الألفبائي.
ب. الألفبائيّة المحوريّة: بمعنى تقسيم الموضوعات إلى محاور، مع اعتماد التسلسل الألفبائي في ترتيب المحاور والمداخل في كلّ محور، بمعنى أنّ ترتيب المداخل ضمن كلّ محور يقوم على أساس التسلسل الألفبائي.
مثال: محور الأعلام:
1ـ أهل البيت^.
2ـ الأصحاب.
3ـ الأعداء.
ويبدأ بالأصحاب، ثمَّ الأعداء، ثمَّ الأهل طبقاً للتسلسل الألفبائي. ثمّ تتبع الطريقة نفسها في المداخل داخل كلّ محور.
ج. طريقة المحاور: بمعنى اتّباع الطريقة الموضوعيّة بغضِّ النظر عن التسلسل الألفبائي.
والمتّبع في هذه الموسوعة هو الطريقة الأُولى الألفبائيّة؛ نظراً لكونها الطريقة الرائجة والعصريّة في كتابة الموسوعات التي تسهيل الأخذ والاستفادة منها.
المفاصل الرئيسة ومراحل العمل
الخطوط العامّة والمفاصل الرئيسة لمراحل العمل وآليّاته؛ التي هي بمثابة البرنامج لكتابة دائرة معارف الإمام الحسين× ما يلي:
1ــ اللجنة العلميّة ومهامّها
هي مجموعة من الباحثين وذوي الاختصاص والخبرة، تقوم بالإشراف على كتابة دائرة المعارف من الناحية العلميّة والفنيّة، ومتابعة جميع مراحل العمل فيها من خلال إعداد برنامج العمل، ووضع الأُسس والضوابط لكتابة المقالات، وتهيئة المفردات والمداخل وإعدادها، وبيان ما هو المدخل الأصلي والإجمالي والدلالي منها ـ التي سيأتي توضيحها لاحقاً ـ ومراجعة المقالات، لتقويم مدى صلاحيّتها للنشر، وتسجيل الملحوظات والإشكالات ـ إن وجدت ـ لإصلاحها ورفعها من قبل الكاتب أو الهيئة العلميّة، والتواصل مع الكتّاب والباحثين، والإشراف على الإخراج النهائي، وغير ذلك.
2ــ لجنة المتابعة والتدقيق
وهي لجنة تقوم بإحصاء المداخل وتدقيقها، وكتابة تقرير إجمالي عن كلّ مدخل، مضافاً إلى المراجعة الأوّليّة للمقالات من أجل رفع النقص على مستوى المعلومات والمصادر، كما تقوم بتدقيق المصادر الواردة في المقالة وتنظيمها من حيث القدم والأهمّية.
3ــ المداخل أو المفردات
أ. تعريف المدخل
المدخل (Entrance) هو عبارة عن عنوانٍ أو اصطلاحٍ لكلّ مقالة من مقالات دائرة المعارف، تدور حوله تلك المقالة، ويتمّ تعيينه من قبل اللجنة العلميّة في دائرة المعارف.
ب. أنواع المداخل
المداخل على ثلاثة أنواع:
1ـ أصلي: وهو المدخل الذي تندرج تحته جميع المسائل التي ترتبط بالموضوع، ولا يوجد مكان آخر أنسب لذكرها وبحثها منه، كـ(الحسين بن علي÷)، فإنّه يُبحث تحت هذا العنوان كلّ ما يرتبط بالإمام، من ولادته، وحسبه، ونسبه، وإمامته، ونهضته المباركة، على أن يفصّل ما يرتبط بالنهضة تحت عنوان: النهضة أو الثورة الحسينيّة، أو غير ذلك حسب ما يُقرّر في حينه.
2ـ إجمالي فرعي: وهو الذي تندرج تحته بعض الفروع والمسائل التي يناسب شرحها وتفصيلها في أماكن أخرى، فيقتصر على ذكرها إجمالاً، ثمّ يحال التفصيل إلى تلك المواضع والمداخل الأخرى. كمدخل أنصار الحسين×؛ إذ تذكر تحته المباحث العامّة المرتبطة بالموضوع، كعددهم وشجاعتهم، وكلّ ما يتعلّق بهم بوصفهم مجموعة، وتترك تفاصيل ما يتعلّق بكلّ واحد منهم إلى عنوانه الخاصّ.
3ـ دلالي: وهو المدخل الذي يحال رأساً إلى ما هو مرادف له أو أشهر منه أو غير ذلك، مثل: بطلة كربلاء، حيث يذكر ويحال إلى زينب بنت علي÷، وبالشكل التقريبي التالي:
بطلة كربلاء = زينب بنت علي÷
ومن الموارد التي يكون فيها المدخل دلالياً:
1ـ أن يكون المدخل أقلّ شهرة من غيره، فيحال إلى ما هو أشهر، مثل «لوط بن يحيى»، فإنّه يحال إلى «أبو مخنف».
2ـ أن يكون جزءاً من مدخل آخر، أو شرطاً فيه فقط، وليس فيه بحث يقتضي إفراده، مثل إذن الدخول؛ فإنّه يحال إلى زيارة الحسين×؛ لأنّه جزء من آداب الزيارة.
3ـ يحال المدخل الناقص كالكنية أو اللقب إلى الاسم الكامل، مثل: ابن سعد؛ فإنّه يحال إلى عمر بن سعد، وابن زياد إلى عبيد الله بن زياد إن لم يكن هو الأشهر الأعرف.
وكذا يحال ما هو غير صحيح إلى ما هو صحيح إن وجد.
تنبيه
لا يصحّ إرجاع المدخل الدلالي إلى مدخل دلالي أيضاً، فعلى سبيل المثال: لا يحال ابن مرجانة إلى ابن زياد؛ لأنّ الثاني يحال إلى عبيد الله بن زياد، بل لابدّ من إحالة ابن مرجانة إلى عبيد الله بن زياد أيضا.
ج. خصائص المدخل أو المفردة
أ. أن يكون حاكياً ومعبّراً عن الموضوع، بحيث يفهم المخاطب موضوع المقالة بمجرّد قراءة العنوان.
ب. أن يكون معروفاً ومتبادراً إلى الأذهان، بحيث يكون مأنوساً لدى المخاطب، وغير غريب عن ذهنه.
ج. أن يكون مستعملاً ومتداولاً، فتترك المداخل المستعملة في فترة زمنيّة معيّنة إلّا أنّها لم تجد طريقها لتكون مصطلحاً معروفاً، نعم لا بأس في ذكرها بوصفها مدخلاً دلاليّاً، وإحالتها إلى المدخل المتداول المعروف.
د. أن يكون جزئيّاً وخاصّاً، باستثناء بعض الحالات، كما لو كان العنوان الجزئي مخالفاً لطريقة دائرة المعارف، كمدخل (سيف) الذي لا يناسب أن يكون عنواناً؛ لأنّ ذلك يستلزم اعتبار الأدوات والأسلحة الأُخرى في كربلاء مداخل أيضاً، فلا بدّ من مدخلٍ كلّي يجمع تلك الوسائل والآلات، كـ (آلات الحرب).
د. ترتيب المداخل
يكون ترتيب المداخل ترتيباً ألفبائيّاً، طبقاً للحروف الهجائيّة العربيّة. ومن تشترك معها في رسم الحرف كالفارسيّة، أما المصطلحات والمفردات اللآتينية فتترجم إلى العربية ثم تذكر بلغتها الأصلية بين قوسين مثل آرثر (Arthur).
هـ. معايير المدخل الحسيني
تتنوّع مداخل ومصطلحات دائرة معارف الإمام الحسين×؛ لتناولها علوماً ومعارف مختلفة؛ إذ تشمل المجالات الكلاميّة والفكريّة والثقافيّة والتاريخيّة والجغرافيّة والرجاليّة وغيرها، من هنا لا بدّ من وضع ضوابط وقواعد يتمّ بموجبها اختيار المداخل، وقد قامت اللجنة العلميّة بوضع ضوابط لا بدّ من توافر واحد منها أو أكثر في المصطلح أو المفردة كي يُعدّ من مداخل دائرة المعارف.
وبما أنّ الضوابط تتنوّع بتنوّع العلوم والمعارف أيضاً، ارتأت اللجنة وضع ضوابط لكلّ حقل من تلك الحقول، وبيان معايير المدخليّة في ذلك المجال، رغم أنّ بعض الضوابط عامّة ومشتركة، كارتباط المدخل والمفردة بالإمام الحسين× وثورته المباركة.
أوّلاً: المفاهيم
أ. الضوابط والمعايير
هناك عدّة معايير للمفاهيم التي تصلح لأن تكون مداخل ومفردات في دائرة معارف الإمام الحسين×، هي:
1ـ التأثير الخاصّ في التعرّف على أبعاد شخصيّة الإمام الحسين×.
2ـ التأثير الواضح في بيان معالم النهضة الحسينيّة وأهدافها.
3ـ الارتباط المباشر في تجسيد المبادئ الحسينيّة على أرض الواقع.
ومن تلك العناوين التي تنطبق عليها المعايير المذكورة أو بعضها: الإصلاح، والحريّة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإباء، والتضحية، ونحو ذلك.
ب. المحاور
وتتمثّل مداخل المفاهيم في المحاور التالية:
1ـ العناوين الكلاميّة والعقديّة، كشفاعة الإمام الحسين×، وإمامته، ومعجزاته، وكراماته. وتدخل في هذا المحور العناوين الفلسفيّة والعرفانيّة والأخلاقيّة.
2ـ المبادئ والقيم الحسينيّة، كالشهادة والإيثار.
3ـ المفاهيم المنحرفة والمضادّة للمبادئ الإسلاميّة والإنسانيّة، كالخذلان والتخاذل عن نصرة الحسين×، والطغيان.
4ـ الشعارات الحسينيّة، أعمّ من الشعارات التي أُطلقت في عاشوراء من قبل الإمام الحسين× أو أصحابه، كشعار (هيهات منّا الذلة) أو التي نشأت بعد ثورة الإمام الحسين×، كـ (يا لثارات الحسين).
5ـ الزيارات والأدعية المختصّة.
6ـ خطب الإمام الحسين× وكلماته.
ثانياً: الثقافة والأدب والفن
تشتمل دائرة معارف الإمام الحسين× على كثير من المداخل الأدبيّة والثقافيّة والفنيّة ونحو ذلك من العلوم والمعارف، ولأجل ضبط المعيار في مدخليّة كلّ عنوان في هذه الدائرة نذكر المعايير التالية، ومن ثمّ المحاور:
أ. الضوابط والمعايير
1ـ الارتباط بالإمام الحسين×.
2ـ الشهرة الثقافيّة والأدبيّة.
3ـ الدور البارز في أدبيّات وثقافة عاشوراء.
4ـ الأهمّية الثقافيّة والفنيّة والأدبيّة.
ب. المحاور
1ـ أدب عاشوراء، مثل: مسرحيّة الحسين ثائراً والحسين شهيداًً.
2ـ الشعر الحسيني.
3ـ الآثار والفنون التي لها ارتباط بالإمام الحسين×، من رسوم وملصقات ولوحات فنيّة ونحت.
4ـ الشعائر الحسينيّة ورسومها، كالمنبر الحسيني، والمواكب والمسيرات الحسينيّة.
5ـ ظواهر ورسوم حسينيّة كالسقاية.
6ـ الأعمال التمثيليّة، مثل الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمشاهد التمثيلية، كمسلسل المختار، وغيره.
7ـ مواقع الإنترنت وبرامج الحاسوب الإلكترونيّة، وغيرها.
ثالثاً: المسائل التاريخيّة
تشغل الوقائع والأحداث التاريخيّة حيّزاً كبيراً فيما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته. وضوابط المداخل التاريخيّة ومحاورها ما يأتي:
أ. الضوابط والمعايير
1ـ الارتباط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة.
2ـ التأثير البارز والدور المهم في القضيّة الحسينيّة.
3ـ الأهمّية والمكانة الكبيرة في حوادث كربلاء.
4ـ الشهرة التاريخيّة.
5ـ الورود في المصادر.
ب. المحاور
1ـ الإخبارات والتنبّؤات والرؤى التي حصلت للأنبياء^ وللرسول‘ والأئمة وبعض الصالحين قبل ولادة الإمام الحسين×، أو عندها والتي تتعلق بمكانته وشهادته وما يجري عليه وغير ذلك.
2ـ الحوادث المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته من ولادته حتّى شهادته، مثل: الهجرة، الامتناع عن البيعة، وصيّته لمحمد بن الحنفيّة.
3ـ القضايا المتعلّقة بالنهضة الحسينيّة بعد عاشوراء حتّى رجوع السبايا إلى المدينة، كالسبي وحمل الرؤوس.
4ـ الوقائع المرتبطة بالقضيّة الحسينيّة من رجوع السبايا وإلى يومنا الحاضر، كهدم المرقد الشريف.
5ـ الثورات والانتفاضات المرتبطة بالنهضة الحسينيّة، مثل ثورة المختار وثورة التوّابين.
6ـ الحكومات والإمام الحسين×، مثل: الدولة البويهية والدولة الصفوية.
7ـ الأزمنة والأوقات، مثل: ليلة عاشوراء، ويوم عاشوراء، وتاسوعاء.
8ـ الاصطلاحات العسكريّة المتعلّقة بالنهضة الحسينيّة، مثل حامل اللواء.
9ـ آلات المعركة ووسائلها، مثل: ذو الجناح، وذو الفقار.
10ـ القبائل والعشائر والأُسر التي كان لها دور بارز في واقعة عاشوراء، مثل: آل عقيل وبنو أسد.
11ـ الأنبياء والملائكة^، مثل: يحيى× وفطرس.
رابعاً: الأعلام
أ. الضوابط والمعايير
1ـ الارتباط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة، أو الثورات التي تُعدّ امتداداً لها.
2ـ الشهرة والاقتران بالنهضة الحسينيّة.
2ـ الدور الفعّال والتأثير الإيجابي أو السلبي.
3ـ الورود في المصادر والكتب.
ب. المحاور
1ـ أهل بيت الإمام الحسين÷، إخوانه، وأخواته، وزوجاته، وأولاده، وبنو عمومته، كأبي الفضل العبّاس وعلي الأكبر، ومسلم بن عقيل، وزينب وليلى والرباب.
2ـ أصحاب الإمام الحسين× والشخصيّات التي لها نحو ارتباط بالنهضة الحسينيّة، كجابر بن عبد اللّه الأنصاري، ومحمد بن الحنفيّة، وابن عبّاس، والطرمّاح.
3ـ شهداء النهضة الحسينيّة، كحبيب بن مظاهر، وزهير بن القين.
4ـ رواة حادثة كربلاء، كحميد بن مسلم.
5ـ الشخصيّات التي سُجنت أو أُعدمت، سواء أكان قبل النهضة المباركة أم بعدها، وكان ذلك بسبب الارتباط بالإمام الحسين× ونهضته، كسليمان بن صُرد، وعبد اللّه بن عفيف الأزدي.
6ـ الحكّام والوزراء والقادة وغيرهم من الشخصيّات السياسيّة والاجتماعيّة التي لها دور إيجابي أو سلبي، كالمتوكّل العبّاسي، وعبّاس الصفوي.
7ـ الشعراء، كالسيّد حيدر الحلّي، والسيّد جعفر الحلّي، وابن نصّار.
8ـ الخطباء، كالشيخ الوائلي.
9ـ الفنّانون، كالمخرج أحمد درويش مخرج فلم يوم القيامة.
ضوابط الشعراء والخطباء
نظراً لوجود موسوعات ومعاجم كتبت في الخطباء والشعراء الحسينيين من قبل أصحاب الفضيلة والاختصاص، كأدب الطفّ للسيد جواد شبّر، ومعجم شعراء الحسين× للشيخ الهلالي، ومعجم الشعراء الناظمين في الإمام الحسين× للشيخ الكرباسي، ومعجم الخطباء للشيخ الهنداوي، ومعجم خطباء المنبر الحسيني للشيخ الكرباسي، وترجمت هذه الموسوعات والمعاجم للخطباء والشعراء بما فيه الكفاية، شعرنا أنّنا قد لا نأتي بأكثر ممّا هو موجود في تلك المؤلّفات، هذا من جهة، ولكثرة الخطباء والشعراء الناظمين في الإمام الحسين× ونهضته المباركة، بحيث يمكن القول بأنّه لا يوجد شاعر إلّا وله شعر في الحسين× وأهل بيته وصحبه. وكذلك أغلب الخطباء فإن طلّاب العلوم الدينيّة يمارسون التبليغ والخطابة الحسينيّة قدّرنا أنّنا إذا أردنا أن نترجم لكلّ من كان خطيباً حسينيّاً مارس الخطابة والتبليغ، وكلّ من نظم في الحسين× سوف يطغى على الموسوعة الشعراء والخطباء، بحيث يغطّي المساحة الأكبر من الموسوعة، ويكون ذلك على حساب المداخل الأخرى من أعلام أُخرى ومفاهيم ووقائع وأدب وفن وغير ذلك.
نظراً لذلك كلّه وجدّنا أنفسنا أمام خيارين: الأوّل: عدم التعرّض للشعراء والخطباء وإيكال أمرهم إلى تلك المعاجم والموسوعات. والثاني: وضع ضوابط وشرائط تضمن لنا الاقتصار على بعض الشعراء والخطباء، فارتأينا اختيار الثاني، وقمنا بوضع بعض الشروط والضوابط التي يكفي انطباق واحدة منها على الشاعر أو الخطيب لإدخاله ضمن دائرة معارف الإمام الحسين×، وهذه الضوابط هي:
1ـ الشهرة، أن يكون الخطيب أو الشاعر معروفاً ومؤثّراً في الأوساط العامّة والخاصّة. وإن لم يكن مكثراً من الشعر في الحسين×، أو متخصّصاً في الخطابة.
2ـ الإبداع والتجديد، كأن يكون الخطيب أو الشاعر صاحب مدرسة وأُسلوب خاصّ تميّز به، بحيث يُعدّ من المبدعين والمجدّدين.
3ـ التخصّص والتمحّض، بحيث يصدق عليه عنوان الخطيب الحسيني أو الشاعر الحسيني، وليس شاعراً نظم في الحسين× أو مبلّغاً ومرشداً يرتقي المنبر في بعض المواسم والمناسبات فقط.
4ـ الإكثار من النظم في الإمام الحسين× نسبيّاً، بحيث تكون له عدّة قصائد مثلاً، وكذا الخطيب الذي لا بدّ أن يكون معروفاً في الأوساط بهذا الوصف: (خطيب حسيني).
5ـ الميزة والخصوصيّة، كأن يكون شخصيّة علميّة أو أدبيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة بارزة قد نظم في الحسين×، أو تحدّث عنه، وإن لم تصدق علية الضوابط المتقدّمة كأن لم يكن مشهوراً بالخطابة، أو الشعر الحسيني، ولا مكثراً.
6ـ أن يكون الشاعر ـ مثلاً ـ غير مسلم أو غير شيعي.
7ـ شهرة قصيدته أو شعره، أو تأثير محاضراته وخطابته وقوّة محتواها ومضامينها، أو إثارتها لمواضيع مهمّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الضوابط تشمل الرواديد والشعراء الشعبيّين أيضاً.
خامساً: الأماكن والمواقع الجغرافيّة والآثار الحضاريّة
أ. الضوابط والمعايير
1ـ المعروفيّة والشهرة التاريخيّة.
2ـ الأهميّة والمكانة الجغرافيّة أو الاجتماعيّة أو الدينيّة أو غيرها.
3ـ كونها محلّاً لوقوع الحوادث المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة، وما يرتبط بها.
4ـ الانتساب إلى الإمام الحسين×.
5ـ الاشتمال على ما يرتبط بالإمام الحسين×.
ب. المحاور
1ـ الدول والمدن، كالدولة الفاطميّة والكوفة.
2ـ الأماكن والنواحي والنقاط الجغرافيّة، مثل نينوى وزرود.
3ـ المقامات والمزارات والمراقد، كمرقد الإمام الحسين× ومرقد السيّدة زينب‘.
4ـ المساجد والحسينيّات والأوقاف، كمسجد الحنّانة، ومسجد الرأس.
سادساً: المصنّفات الحسينيّة
وتضمّ المخطوطات والكتب الحسينيّة القديمة والحديثة، ودواوين الشعر، والموسوعات، ودوائر المعارف الحسينيّة، والمجلّات والدوريّات الحسينيّة.
أ. الضوابط والمعايير
يكفي في دخول الأثر أو المصنّف الحسيني في هذا القسم انطباق واحد أو أكثر من المعايير التالية عليه:
1ـ الاختصاص بالقضيّة الحسينيّة.
2ـ رصانة المحتوى العلمي.
3ـ التأثير الواسع في الأوساط العلميّة.
4ـ الشهرة والمعروفيّة.
5ـ الحجم، كالتألف من عدّة مجلّدات أو أعداد.
6ـ ندرة الموضوع.
7ـ القِدَم، كأن يكون من مؤلّفات القرون المتقدّمة.
8ـ كون المؤلّف أو الكاتب من المشهورين من غير المسلمين.
9ـ كون الأثر من المصادر والمراجع المهمّة.
10ـ كونه محلّ نقاش وجدل.
11ـ المعالجة لشبهة أو موضوع مهم.
12ـ الامتياز بالإبداع والتحليل والعمق.
13ـ أن لا يكون مستلّاً من تأليف حسيني سابق.
14ـ أن لا يكون تكراراً لأبحاث حسينيّة سابقة.
ب. المحاور
1ـ الكتب الحسينيّة.
2ـ دواوين الشعر الحسيني.
3ـ الموسوعات ودوائر المعارف الحسينيّة.
4ـ المجلّات والدوريّات.
5ـ الأجزاء والأقسام المختصّة بالإمام الحسين× الموجودة ضمن كتب ومؤلّفات أُخرى.
4ــ مقالات دائرة المعارف
أهمّ المفاصل في مقالات دائرة معارف الإمام الحسين× الألفبائيّة ما يلي:
أ. لغة المقالة
لغة مقالات دائرة المعارف هي اللغة العربيّة، وتترجم الأسماء والمفردات والمصطلحات الواردة بلغة أُخرى، كالفارسيّة أو الإنجليزيّة إلى اللغة العربيّة، ثمَّ تذكر بعد ذلك بلغتها الأصليّة.
ب. منهجيّة المقالة وخطّتها
خطّة البحث: هي الهيكليّة الكلّية والفهرست الإجمالي للبحث التي ترسم مفاصله وعناوينه الرئيسية، ثمّ ما يتفرّع عليها من عناوين، وتكون شاملة لكلّ ما يرتبط به من أقسام وأحكام وفروع وأبحاث، وغير ذلك، بتسلسل علمي ومنطقي وفني؛ لتكون القالب الذي تصبّ فيه المعلومات المرتبطة بالموضوع.
وتتكوّن من مفصلين رئيسين هما:
1ـ التعريف: ويذكر تحته التعريف اللغوي والاصطلاحي. والمراد من التعريف اللغوي: بيان معنى المدخل أو المفردة في المصادر اللغويّة والموسوعات والقواميس المعروفة. ويقتصر في التعريف اللغوي على التركيب المراد والمقصود بالبحث، ولا يتعرّض للمعاني الأُخرى المتشعّبة عن تلك المادّة، والتي ليس لها علاقة بموضوع المقال، وفي صورة تعدّد المعنى المتّصل بالمفردة موضوع البحث يركّز على المعروف، ويشار إلى المعاني الأُخرى أيضاً. وأمّا الاصطلاحي: فالمراد به اصطلاح أهل الفنّ في كلّ مجال، وفي صورة الاستعمال بنفس المعنى اللغوي يُنبّه على ذلك، كأن يقال: وتستعمل بالمعنى اللغوي نفسه.
2ـ صلب المقالة: وهو القسم الأكبر والأهم، إذ يشتمل على جميع ما يرتبط بالمدخل من أقسام وأحكام ومعلومات، وغير ذلك.
وهنا يجب مراعاة ما يأتي:
1ـ كتابة خطّة البحث قبل الشروع في كتابة المقال بعد مراجعة المصادر والمعطيات التي تتوفّر لدى الكاتب والاعتماد على معلوماته المسبقة وخلفيّته الذهنيّة، ثمّ تعرض على اللجنة العلميّة لتبدي رأيها، وتُجري عليها الإصلاحات المطلوبة، أو تُسجّل عليها الملحوظات ـ إن كانت ـ ثمّ تعاد إلى الباحث ليشرع بالكتابة في ضوء الخطّة المصوّبة.
2ـ في خطّة البحث ينبغي تفكيك المطالب بالشكل الذي لا يستلزم التداخل والتكرار، وأن تكون عناوينها منظّمة منطقيّاً، متناسبة مع موضوع البحث وطبيعته، مبرزة للمفاصل الرئيسة وما يتفرّع عليها، وينطوي تحتها من عناوين وفروع.
3ـ أن تكون المقالة مستوعبة لجميع ما يرتبط بالبحث من مسائل وفروع. نعم ينبغي أن لا تتجاوز الحدود المناسبة.
4ـ في المقالات الموسّعة تُوزّع المطالب تحت عناوين وأقسام مختلفة، تكون هي العناوين الكلّية والمفاصل الرئيسة للموضوع، ويحتوي كلّ قسم على محاور وعناوين فرعيّة تشترك في الموضوع الكلّي.
ومن أجل صبّ المقالة في قالب علمي ممنهج، والإحاطة بأطراف الموضوع والإلمام به، وتجنّب الحشو والاستطراد، والحفاظ على السياق العامّ لمقالات الموسوعة، كان من الضروري وضع خطّة ومنهجيّة موحّدة لمقالات دائرة معارف الإمام الحسين×، تبيّن الخطوط العامّة والمفاصل الرئيسية للمقالات، وبما أنّ دائرة المعارف تضمّ بين دفتيها أنواعاً مختلفة من العلوم والمعارف، فبطبيعة الحال تختلف وتتنوّع خطّة البحث ومنهجيّة المقال من عِلم لآخر. وإليك النماذج العامّة لهذه المنهجيّة كلّاً حسب حقله وقسمه:
ج. نماذج عامة لمنهجية المقالات وخططها
أوّلاً: المفاهيم
توجد في هذا الحقل عدّة فروع، هي:
1. القضايا الكلاميّة والعقديّة، والمبادئ والقيم الحسينيّة، والعناوين الأخلاقيّة والعرفانيّة، ونحوها.
الخطّة العامّة:
أ ـ التعريف اللغوي والاصطلاحي.
ب ـ المفهوم القرآني أو الروائي.
ج ـ الجذور والسوابق التاريخيّة.
د ـ الجذور والسوابق الفكريّة والثقافيّة.
هـ ـ الارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
وـ الآراء والنظريّات.
2. الزيارات والأدعية
الخطّة العامّة:
أ ـ الخطوط العامّة للمتن.
ب ـ سبب التسمية أو الأسماء الأُخرى، إن وجدت.
ج ـ الراوي للمتن أو الرواة.
د ـ السند.
هـ ـ النسخ والنصوص الأُخرى.
وـ سبب الصدور.
زـ المحتوى والمضمون.
ح ـ الأهمّية والمكانة.
ط ـ الارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
ي ـ الآثار العلميّة والعمليّة.
ك ـ مشخّصات الكتاب والمصدر.
3. الخُطب
الخطّة العامّة:
أ ـ الخطوط العامّة للمتن.
ب ـ الظروف والأجواء المحيطة بالصدور، مثل: الزمان، والمكان، والحضور، والمخاطب، وردود الأفعال.
ج ـ سبب التسمية والأسماء، إن وجدت.
د ـ الراوي للمتن أو الرواة.
هـ ـ السند.
و ـ النسخ والنصوص الأُخرى.
ز ـ سبب الصدور.
ح ـ المحتوى والمضمون.
ط ـ الارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
ي ـ الآثار العلميّة والعمليّة.
4. الشعارات
الخطّة العامّة:
أ ـ التعريف.
ب ـ الأنواع الأُخرى المشابهة.
ج ـ الجذور والسوابق التاريخيّة.
د ـ الخلفيّات الفكريّة والنظريّة.
هـ ـ المكانة والآثار.
و ـ الارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
ز ـ الآثار العلميّة والعمليّة.
ح ـ المجالات التطبيقيّة ومقدار الاستفادة منها.
ثانياً: المداخل الثقافيّة والأدبيّة والفنيّة
1. المصائب الحسينيّة
الخطّة العامّة:
أ ـ بيان النص.
ب ـ الجذور التاريخيّة للأحداث والروايات.
ج ـ بيان اختلاف النصوص والإشارة إلى الصحّيح منها.
د ـ السوابق والسَير التاريخي.
2. الشعائر الحسينيّة
الخطّة العامّة:
أ ـ مباحث تمهيديّة.
ب ـ السابقة التاريخيّة والتطوّر التاريخي.
ج ـ الخلفيّات والمستندات.
د ـ بيان الصورة الأصيلة والحقيقيّة.
هـ ـ الجنبة الفقهيّة.
و ـ التفريق بين المسنون والمُبتدع.
ز ـ المصدر ومدى الانتشار.
ح ـ الأنواع المشابهة الأُخرى.
3. آداب الزيارة
الخطّة العامّة:
أ ـ مباحث تمهيديّة.
ب ـ السابقة التاريخيّة والتطوّر التاريخي.
ج ـ الخلفيّات والمستندات.
د ـ بيان الصورة الأصيلة والحقيقيّة.
هـ ـ الجنبة الفقهيّة.
و ـ التفريق بين المسنون والمبتدع.
4. الشعر والأدب الحسيني
الخطّة العامّة:
أ ـ هويّة الشاعر.
ب ـ زمنه وظروفه السياسيّة والاجتماعيّة.
ج ـ المشخّصات العامّة للشعر، وزنه ونظمه ولغته و... .
د ـ المضامين المهمّة.
هـ ـ موقف الشاعر.
و ـ المصدر.
5. النتاجات الفنيّة
الخطّة العامّة:
أ ـ هويّة الفنّان.
ب ـ مشخّصات العمل الفنيّ.
ج ـ جذوره ومنشؤه وسوابقه التاريخيّة.
د ـ الارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
هـ ـ التأثير الاجتماعي.
و ـ المقارنة بينه وبين أعمال أُخرى.
ثالثاً: المداخل التاريخيّة
1. الحوادث المرتبطة بالنهضة الحسينيّة
الخطّة العامّة:
أ ـ مباحث تمهيديّة.
ب ـ زمان الواقعة ومكانها وجزئيّاتها.
ج ـ الأشخاص المؤثّرون فيها.
د ـ خلفيّات وأسباب حدوثها.
هـ ـ الأرضيّة والسوابق التاريخيّة لها.
و ـ آثارها ونتائجها.
2. خلفيّات النهضة الحسينيّة ومنطلقاتها، التنبؤات والرؤى
الخطّة العامّة:
أ ـ مقدّمة.
ب ـ المشخّصات، القائل، الخبر، زمانه، مكانه، محتواه.
ج ـ مصدره وأدلّة وقوعه.
د ـ آثاره ونتائجه.
3. الحكومات والقبائل والعشائر والأُسر
الخطّة العامّة:
أ ـ المعلومات العامّة، العرق، والقوميّة، والمذهب، والنسب.
ب ـ مناطق السكنى أو السلطة والنفوذ.
ج ـ الأشخاصّ الذين لهم ارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
د ـ الارتباط والعلاقة بالقضيّة الحسينيّة.
4. الثورات والانتفاضات المرتبطة بالنهضة الحسينيّة
الخطّة العامّة:
أ ـ المباحث العامّة.
ب ـ الجزئيّات أو الحوادث المهمّة.
ج ـ القادة والأشخاص المؤثّرون.
د ـ الدوافع والأسباب.
هـ ـ الارتباط والعلاقة بالقضيّة الحسينيّة.
و ـ الآثار والنتائج.
5. الأزمنة والأوقات
الخطّة العامّة:
أ ـ سبب التسمية.
ب ـ الخلفيّة والسابقة.
ج ـ الحوادث التي وقعت فيها.
د ـ المكانة والدور التاريخي.
6. الاصطلاحات العسكريّة وآلات المعركة ووسائلها
الخطّة العامّة:
أ ـ مباحث عامّة.
ب ـ السابقة التاريخيّة.
ج ـ الارتباط والعلاقة بالقضيّة الحسينيّة.
رابعاً: الأعلام
1. أهل البيت^ والشهداء والسجناء والأصحاب
الخطّة العامّة:
أ ـ الهويّة الشخصيّة، اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وقبيلته و... .
ب ـ مولده ووفاته، زماناً ومكاناً.
ج ـ ألقابه وعناوينه.
د ـ سيرته.
هـ ـ كونه من الصحابة أو التابعين.
و ـ مميّزاته وسماته الأخلاقيّة والسياسيّة والعلميّة.
ز ـ العلاقة والارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
2. الرواة والمحدّثون
الخطّة العامّة:
أ ـ الهويّة الشخصيّة، اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وقبيلته و... .
ب ـ مولده ووفاته، زماناً ومكاناً.
ج ـ ألقابه وعناوينه.
د ـ مكانة الراوي، طبقته وثاقته و... .
هـ ـ مضامين رواياته وعددها.
و ـ سيرته.
ز ـ العلاقة والارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
3. شخصيات لها دور وأثر إيجابي أو سلبي في القضيّة الحسينيّة
الخطّة العامّة:
أ ـ الهويّة الشخصيّة، اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وقبيلته، و... .
ب ـ مولده ووفاته، زماناً ومكاناً.
ج ـ ألقابه وعناوينه.
د ـ سيرته.
هـ ـ دوره الإيجابي أو السلبي في القضية الحسينيّة.
4. الفنّانون البارزون الذين لديهم أعمال بارزة ترتبط بالنهضة الحسينيّة
الخطّة العامّة:
أ ـ الهويّة الشخصيّة، اسمه، ونسبه، ولقبه، وكنيته، وقبيلته و... .
ب ـ مولده ووفاته، زماناً ومكاناً.
ج ـ ألقابه وعناوينه.
د ـ سيرته.
هـ ـ مكانته الفنيّة.
و ـ العلاقة والارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
خامساً: المداخل الجغرافيّة
1. الدول والمدن والأماكن التي جرت فيها الحوادث الحسينيّة
الخطّة العامّة:
أ ـ التسمية وسببها والأسماء الأُخرى إن وجدت.
ب ـ المعالم الطبيعيّة والجغرافيّة، الموقع الجغرافي، الطول والعرض، الارتفاع عن سطح البحر، المناخ، عدد السكّان، البناء والعمران.
ج ـ السابقة التاريخيّة والحوادث المهمّة التي وقعت فيها.
د ـ القبائل والأقوام والأديان والمذاهب.
هـ ـ الوضع الاقتصادي، التعليمي، الصحّي، المواصلات.
و ـ الآثار التاريخيّة.
ز ـ الأهمّية السياسيّة والثقافيّة.
ح ـ الارتباط بالمسألة الحسينيّة.
2. الأماكن والنواحي والنقاط الجغرافيّة التي مرّ بها الإمام الحسين×.
أ ـ التسمية وسببها والأسماء الأُخرى إن وجدت.
ب ـ المعالم الطبيعيّة والجغرافيّة سابقاً وحالياً.
ج ـ السابقة التاريخيّة والحوادث المهمّة التي وقعت فيها.
د ـ الأهمّية السياسيّة والثقافيّة.
هـ ـ الارتباط بالقضيّة الحسينيّة.
3. المقامات والمزارات والمراقد المهمّة
الخطّة العامّة:
أ ـ سبب التسمية والأسماء الأُخرى إن وجدت.
ب ـ المعالم العامّة.
ج ـ وضع البناء والتحوّلات التي جرت عليه.
د ـ السابقة التاريخيّة.
هـ ـ التأثير السياسي والاجتماعي والثقافي.
و ـ الوضع الإداري والنشاطات العامّة.
4. المساجد والحسينيّات والأوقاف المهمّة
الخطّة العامّة:
أ ـ التسمية وسببها والأسماء الأُخرى إن وجدت.
ب ـ المعالم العامّة.
ج ـ المؤسّس، المؤسّسون.
د ـ السابقة التاريخيّة.
هـ ـ المكانة والأهمّية السياسيّة والثقافيّة والاجتماعيّة.
و ـ النشاطات الوعظية والتبليغية وغيرها.
ز ـ العلاقة بالقضيّة الحسينيّة.
سادساً: الكتاب الحسيني
الخطّة العامّة:
أ ـ هويّة المؤلف.
ب ـ خلفيّة المؤلف الفكريّة والثقافيّة والسياسيّة.
ج ـ أسباب التأليف وظروفه وزمنه ومكانه.
د ـ المضامين العامّة للكتاب.
هـ ـ الخصائص العلميّة والفنيّة للكتاب.
و ـ مكانته وتأثيره.
ز ـ آراء العلماء والنُقّاد.
ح ـ شروحه ونسخه وطبعاته.
د. كيفيّة المقالة وشرائطها
1ـ يتناسب حجم كلّ مقال مع الموضوع المبحوث عنه، على أن يُراعى في ذلك الاختصار قدر الإمكان، شريطة أن لا يكون مُخلّاً، ويتجنّب التوسّع والاستطراد والتكرار والتوضيحات غير الضروريّة والاستدلالات الضعيفة والآراء الشاذّة، ونحو ذلك، ممّا لا ينفع القارئ والباحث، ولا يغني الفكرة، ولا يناسب مقالات دائرة المعارف والأهداف المتوخّاة منها.
2ـ يتجنّب الإفراط والتفريط في مقدار المقالة ولغتها. ومن أبرز أمثلّة الإفراط: استخدام الاصطلاحات الصعبة وغير الرائجة والعبارات المضغوطة التي لا يتمكّن القارئ من فهمها إلّا من خلال الاستعانة بالمتخصّص. ومن الأشكال البارزة للتفريط: الكتابة بلغةٍ عامّية وأُسلوب فضفاض لا يحافظ على لغة العلم، ولا يستسيغه الذوق السليم، فإنّ الأُسلوبين مرفوضان في الكتابة بشكل عام، وفي مقالات دائرة المعارف بصورة خاصّة.
3ـ عادة تكتب المقالة بلغة الحكاية ونقل الآراء والأدلّة والمناقشات، بعيداً عن القناعات الشخصيّة للكاتب، المبنيّة على التعصّب لرأي والانتصار له على حساب آخر، أو نحو ذلك، بل ينبغي للكاتب إبراز الآراء مع أدلّتها وما تستند إليه، ونقاط القوّة والضعف فيها بكلّ حياديّة وموضوعيّة، وهذا لا يمنع من ترجيح رأي على آخر بناء على المعطيات والأدلّة المتوفّرة لدى الكاتب.
4ـ يراعى في هيكليّة المقالة وعناوينها الأصلية والفرعيّة التبويب والترتيب الفني والمنطقي والذوقي، والانسجام بينها وبين المعنونات، ويتجنّب الحشو والتكرار والتداخل.
5ـ يقتصر على موضع الشاهد من الآيات والروايات والنصوص الأدبيّة والشعر ونحو ذلك، بشرط أن لا يكون مخلّاً، أو تكون هناك ضرورة لنقل النصّ بالكامل أو بعضه.
6ـ يراعى في الحوادث والوقائع ونحوها ذكر التواريخ، ويكتفى بالتاريخ الهجري القمري والميلادي، ويقدّم الهجري على الميلادي، ولا داعي لذكر اليوم والشهر إلّا مع الضرورة.
7ـ تكتب الأسماء والمصطلحات اللاتينيّة بلغتها الأصلية بعد كتابتها باللغة العربيّة، ويوضع الاسم المكتوب باللغة الأصلية بين قوسين، على أن يكتب الحرف الأوّل منه بالحرف الكبير (Capital letter).
8ـ في حال حاجة المقالة إلى أُمور تكميليّة ـ كالخرائط والجداول والمشجّرات ونحو ذلك ـ ينبغي على الكاتب القيام بذلك، إلّا في صورة عدم تمكّنه من ذلك لأيّ سببٍ كان؛ فحينئذٍ يوكل ذلك إلى الجهات المختصّة في دائرة المعارف، بعد التوصية وتهيئة المواد من قبل الكاتب قدر الإمكان.
9ـ يقتصر في الأُمور التكميليّة التي تلحق في المقال على الأشكال والرسوم والخرائط والمراقد والآثار وما شابه ذلك، دون الصور الشخصيّة، وفي حدود ما يقتضيه التوضيح الوارد في المقال.
هـ. أُسلوب الكتابة
أُسلوب الكتابة موسوعي، يتناسب مع طبيعة الكتابة في دائرة المعارف، يُتجنّب فيه السّرد والاستطراد والتكرار، وتُراعى فيه طبيعة المُخاطب، ويحافظ فيه على الدّقة العلميّة، والأمانة في النقل والتوثيق، والموضوعيّة في عرض الأفكار، واحترام كافّة الآراء، ومحاولة الإبداع في العرض والبيان بما يتناسب مع لغة العصر.
ويُراعى فيه أيضاً ما يلي:
1ـ الحفاظ على الهيكليّة العامّة والمفاصل الكلّية والرئيسة التي تشترك فيها جميع المقالات الموسوعيّة، وعدم الخروج عنها إلى نمط وأُسلوب آخر.
2ـ الابتعاد عن اللغة الخطابيّة والأدبيّة الفضفاضة، فيجب أن تكون لغة الكتابة رصينة جامعة بين الدقّة العلميّة ووضوح التعبير.
3ـ الجمع بين لغة الاختصاص واصطلاحاته وسهولة التعابير، فإنّ كلا الأمرين مطلوب؛ إذ لا بدّ من الحفاظ على لغة العلم مع السعي إلى العرض بأسلوب يتناسب مع لغة العصر ومتطلّباته.
4ـ الدقّة في ترجمة المقالات المكتوبة بلغة أُخرى غير العربيّة، كاللغة الفارسيّة أو الإنجليزيّة أو غيرهما، وصياغتها بالشكل الذي يتناسب مع طريقة الموسوعة.
5ـ تجنّب عبارات المدح والثناء، إلّا من استثني من الأنبياء والأئمّة^ وبعض الأصحاب، كما يُتجنّب الذم، فعند ذكر بعض الشخصيّات الظالمة، يقتصر على ذكر أفعالهم القبيحة دون توصيفهم بكلماتٍ نابية.
6ـ تجنّب العبارات العاطفية، إلّا مع الضرورة.
7ـ تشتمل دائرة معارف الإمام الحسين× على علوم متعدّدة واختصاصات متنوّعة، فينبغي الاستفادة من اصطلاحات تلك العلوم رغم التداخل بين بعض العلوم كعلمي الرجال والدراية والتاريخ، فلا بدّ من الالتفات إلى ذلك تجنّباً للبس والإبهام.
ز . التوثيق
يُراعى في التوثيق الأُمور التالية:
1ـ توثّق كلّ معلومة أو دليل أو مناقشة، أو ما شابه ذلك من خلال ذكر المصدر.
2ـ يذكر المصدر في الحاشية وعلى الشكل التالي: اسم الكتاب، الجزء، الصفحة، مثل: تاريخ الطبري2: 124. على أن تذكر التفاصيل في فهرست المصادر في آخر المقال وعلى النحو التالي: اسم الكتاب بشكل كامل، اسم المؤلّف ولقبه، المحقّق ـ إن وُجد ـ الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة وتاريخها.
وأمّا إذا كان المصدر نشريّة أو مجلّة فيذكر اسمها مع رقم العدد والصفحة وعنوان المقال واسم الكاتب، على أن يكتب في فهرست المصادر اسم المجلّة والجهة أو الشخص أو المؤسّسة المصدّرة لها وتاريخ الإصدار مثل: «مجلّة الإصلاح الحسيني، مؤسّسة وارث الأنبياء، العدد 25 لسنة 1438هـ، 2017م» وفي المواقع الإلكترونية يقتصر على اسم الموقع والرابط الإلكتروني ويكرر ذلك في الموضعين.
3ـ في حال تعدد اسم المصدر يعتمد في الحاشية الاسم المشهور، في حين يذكر في فهرست المصادر الاسم الأصلي للكتاب، ويوضع الاسم المشهور بين قوسين.
4ـ في صورة التشابه في الاسم بين بعض المصادر كالأمالي مثلاً، يكتب اسم المؤلّف بين قوسين بعد اسم المصدر، مثل: الأمالي (المفيد).
5 ـ يُتجنّب ذكر اسم المصدر في المتن ـ قدر الإمكان ـ بعد البناء على ذكره في الحاشية، إلّا في بعض الحالات التي يناسب فنيّاً ذكر اسم المصدر.
6ـ تعتمد المصادر الأصليّة للمعلومات، دون الثانويّة، إلّا في حالات الضرورة.
7ـ يُنقل عن المصدر بشكل مباشر، دون النقل عن الواسطة، إلّا في حالات الضرورة، فإنّه ينقل عن الواسطة مع التنبيه على ذلك.
8ـ تعتمد جميع المصادر، ويتعامل معها بموضوعيّة تامّة، ولا يعني ذلك الاعتماد على المصادر من دون ملاحظة الغايات التي من أجلها كُتب الكتاب، وأهداف الكاتب وخلفيّته الفكريّة والسياسيّة، ككتب بعض المستشرقين، والإسلاميين المتطرّفين، فإنّها قد تحتوي على معلومات غير دقيقة، أو تحليلات تبتني على الخلفيّة الفكريّة لأصحابها، أو تكون ناشئة عن التعصّب وما شابه ذلك، فإنّه لا بدّ من التعامل مع هكذا مصادر وكتابات بحيطة وحذر. ويهمل المصدر الذي لم يعتمد الموضوعيّة والتحقيق، ولم يتوخَّ الدقّة والأمانة، إلّا إذا أُريد الردّ عليه. كلّ ذلك مع التركيز على الأفكار والآراء والابتعاد عن الشخصنة والمهاترات، وتجنّب العبارات النابية والركيكة.
9 ـ ينبغي التنوّع في المصادر، والاستفادة في أخذ المعلومات من جميع الآثار المكتوبة وغير المكتوبة، كالكتب والمقالات، والرسائل العلميّة، والبحوث الجامعيّة، ومواقع الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والآراء المطروحة في المراكز العلميّة، والمحاضرات المرئيّة وغير المرئيّة، والبحوث الميدانيّة التوثيقيّة، فيما إذا اشتملت على معلومات مهمّة، أو إثارات جديدة لم تكن مطروحة في المصادر الأصليّة أو الثانويّة.
10ـ يعتمد كلّ مصدر له علاقة بالموضوع، بغضّ النظر عن لغته، بشرط توفّر الشرائط الموضوعيّة والعلميّة.
11ـ في صورة تعدّد النسخ تعتمد النسخة المحقّقة والمدقّقة والمشتملة على توضيحات علميّة، من هنا؛ لا يكون القِدَم الزماني وحده ملاكاً لتقديم النسخة، بل ينبغي أن تلاحظ المزايا المذكورة.
12ـ يجب مراعاة التسلسل التاريخي، أو الأهمّية من الناحية العلميّة في أخذ المعلومات وتوثيقها.
13ـ في حال تعدّد المصادر وتنوّعها، يقتصر على أهمّها.
14ـ الأصل في الاقتباس من المصادر هو النقل بالمضمون مع مراعاة الدقّة والأمانة، وعدم النقل بالنصّ؛ لأنّ نقل المتون بالنصّ يؤدّي إلى الإطالة المنافية لطريقة كتابة الموسوعات والأغراض المتوخّاة منها. يستثنى من ذلك حالات معيّنة، مثل: الاستشهاد بالنصّ، أو إرادة شرحه، أو التعليق عليه، أو نحو ذلك مما يستوجب نقله.
اللجنة العلميّة في دائرة معارف الإمام الحسين× (الألفبائيّة)