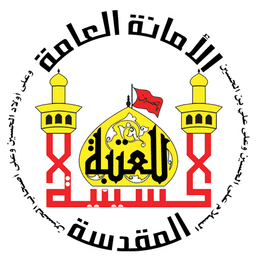مقدمة المؤسّسة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقية وسعادته الأبدية المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدد اختيارات الإنسان الصحيحة، وعلى ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله عز وجل على سائر المخلوقات، واحتج عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)([1])، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، وقد جاء في الأثر «العلمُ نورٌ»([2])، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله عز وجل، إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)([3])، وبهما تسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله عز وجل بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)([4])، و(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)([5])، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاؤهم^ ومبتغاهم من الله عز وجل لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»([6]).
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه هي سيرة الأنبياء والأئمة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبي أو وصي، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أنيطت بهم^، كما أخبر عز وجل بذلك في قوله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)([7])، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقية سير الأنبياء، كما أنّ سيرة الأئمة^ ليست كبقية سير الأوصياء السابقين، كما أنّ التفاوت في سير الأئمة^ فيما بينهم مما لا شك فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقية الأئمة^.
والإمام الحسين× تلك الشخصية القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة التي دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الرباني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصية العظيمة التي ملأت أركان الوجود تعلَّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفية والعملية، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمس الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قبل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم وأفنوا أغلى أوقاتهم وزهرة أعمارهم لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفية التي تركها× للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفية في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: بل هي أكثر مما تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعددة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤولية المهتمين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق؛ بادرت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكرية والعلمية حول شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى والأساس بمسك هذا الملف التخصصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسية، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، التابعة للعتبة الحسينية المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميين ـ على شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطة مبرمجة وآلية متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلمية التخصصية، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينية المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصية الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلمية في المؤسسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسَّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلمية في المجال الحسيني، تمّ الوقوف على مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهميته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويات المعتمد في المؤسَّسة تمّ اختيار المشاريع العلميّة الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعية للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينية التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلمية وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث المكتوب عن مقتل الإمام الحسين×، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ ليتمَّ جمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتمُّ استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسَّسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد إخضاعها للتقييم العلمي من قبل اللجنة العلمية في المؤسَّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر تقوم المؤسَّسة بطباعتها.
الثاني: مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية والفقهية والأدبية في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلات العلمية الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلمية الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينية
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونية وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علميّ تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×
وهي موسوعة علمية تخصصية مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون ذلك من خلال جمع كلمات الإمام الحسين× من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية مع بيان لتلك الكلمات، ثمّ وضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام× والواقع العلمي.
الخامس: قسم دائرة معارف الإمام الحسين× أو (الموسوعة الألفبائية الحسينية)
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام وبلدان وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ حديث.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
إنّ العمل في هذا القسم يتمحور حول أمرين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة من قبل اللجنة العلمية في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية، تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
يقوم هذا القسم بمتابعة التراث المكتوب حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة باللغات غير العربية لنقله إلى العربية، ويكون ذلك من خلال تأييد صلاحيته للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ترجمته إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية في شتّى المجالات.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات العلمية
ويتمّ العمل في هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكرية متخصّصة في النهضة الحسينية، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، كما تتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلمية في المؤسَّسة، وكذا سائر الباحثين والمحققين وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينية وفق الأدوات الاستنباطية المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينية التخصصية
وهي مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسَّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصُّصها.
الحادي عشر: قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصِّص بنشر نتاجات وفعاليات مؤسَّسة وارث الأنبياء، يقوم بنـشر وعرض كتبها ومجلاتها التي تصدرها، وكذا الندوات والمؤتمرات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسَّسة، ومجمل فعالياتها العلمية والإعلامية.
الثاني عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصص وبأقلام علمية نسوية في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبية، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الثالث عشر: القسم الفني
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسَّسة، من خلال برامج إلكترونية متطوِّرة يُشرف عليها كادر فنيّ متخصِّص، يعمل على تصميم الأغلفة وواجهات الصفحات الإلكترونية، وبرمجة الإعلانات المرئية والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها كافّة الأقسام.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.
قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء
يتكفّل قسم الرسائل والأطاريح الجامعية بمهمّة نشر الفكر الحسيني المبارك، من خلال تفعيل الدراسات والأبحاث العلمية الحسينية في الأوساط الجامعية والأكاديمية بمستوياتها الثلاثة: البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، مضافاً إلى الرُقي بالمستوى العلمي والتحقيقي للكفاءات الواعدة المهتمّة بالنهضة الحسينية في جميع مجالاتها. وقد تصدّى لهذه المسؤولية نخبة من الأساتذة المحقِّقين في المجال الحوزوي والأكاديمي.
أهداف القسم
الغاية من وراء إنشاء هذا القسم جملة من الأهداف المهمّة، منها:
1ـ إخضاع الدراسات والأبحاث الحسينية لمناهج البحث المعتمَدَة لدى المعاهد والجامعات.
2ـ إبراز الجوانب المهمّة وفتح آفاق جديدة أمام الدراسات والأبحاث المتعلّقة بالنهضة الحسينية، من خلال اختيار عناوين ومواضيع حيوية مواكبة للواقع المعاصر.
3ـ الارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر الجامعية، والعمل على تربية جيل يُعنَى بالبحث والتحقيق في مجال النهضة الحسينية الخالدة.
4ـ إضفاء صبغة علمية منهجية متميزة على صعيد الدراسات الأكاديمية، المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة.
5ـ تشجيع الطاقات الواعدة في المعاهد والجامعات؛ للولوج في الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف مجالات البحث المرتبطة بالنهضة الحسينية، ومن ثَمّ الاستعانة بأكفّائها في نشر ثقافة النهضة، وإقامة دعائم المشاريع المستقبلية للقسم.
6ـ معرفة مدى انتشار الفكر الحسيني في الوسط الجامعي؛ لغرض تشخيص آلية التعاطي معه علمياً.
7 ـ نشر الفكر الحسيني في الأوساط الجامعية والأكاديمية.
8 ـ تشخيص الأبعاد التي لم تتناولها الدراسات الأكاديمية فيما يتعلّق بالنهضة الحسينية، ومحاولة العمل على إبرازها في الدراسات الجديدة المقترحة.
9ـ التعريف بالرسائل الجامعية المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ والتي تمّت كتابتها ومناقشتها في الجامعات.
آليات عمل القسم
إنّ طبيعة العمل في قسم الرسائل والأطاريح الجامعية تكون على مستويات ثلاثة:
المستوى الأوّل: العناوين والمواضيع الحسينية
يسير العمل فيه طبقاً للخطوات التالية:
1ـ إعداد العناوين والموضوعات التخصّصية، التي تُعنَى بالفكر الحسيني طبقاً للمعايير والضوابط العلمية، مع الأخذ بنظر الاعتبار جانب الإبداع والأهمية لتلك العناوين.
2ـ وضع الخطّة الإجمالية لتلك العناوين والتي تشتمل على البحوث التمهيدية والفصول ومباحثها الفرعية، مع مقدّمة موجَزَة عن طبيعة البحث وأهميته والغاية منه.
3ـ تزويد الجامعات المتعاقد معها بتلك العناوين المقترَحَة مع فصولها ومباحثها.
المستوى الثاني: الرسائل قيد التدوين
يسير العمل فيه على النحو التالي:
1ـ مساعدة الباحث في كتابة رسالته من خلال إبداء الرأي والنصيحة.
2ـ استعداد القسم للإشراف على الرسائل والأطروحات فيما لو رغب الطالب أو الجامعة في ذلك.
3ـ إنشاء مكتبة متخصِّصة بالرسائل الجامعية؛ لمساعدة الباحثين على إنجاز دراساتهم ورسائلهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من مكتبة المؤسَّسة المتخصّصة بالنهضة الحسينية.
المستوى الثالث: الرسائل المناقشة
يتمّ التعامل مع الرسائل التي تمّت مناقشتها على النحو التالي:
1ـ وضع الضوابط العلمية التي ينبغي أن تخضع لها الرسائل الجامعية، تمهيداً لطبعها ونشرها وفقاً لقواعد ومقرَّرات المؤسَّسة.
2ـ رصد وإحصاء الرسائل الأكاديمية التي تمّ تدوينها حول النهضة الحسينية المباركة.
3ـ استحصال متون ونصوص تلك الرسائل من الجامعات المتعاقَد معها، والاحتفاظ بها في مكتبة المؤسَّسة.
4ـ قيام اللجنة العلمية في القسم بتقييم الرسائل المذكورة، والبتِّ في مدى صلاحيتها للطباعة والنشر من خلال جلسات علمية يحضرها أعضاء اللجنة المذكورة.
5ـ تحصيل موافقة صاحب الرسالة لإجراء التعديلات اللازمة، سواء أكان ذلك من قبل الطالب نفسه أم من قِبل اللجنة العلمية في القسم.
6ـ إجراء الترتيبات القانونية اللازمة لتحصيل الموافقة من الجامعة المعنِيَّة وصاحب الرسالة على طباعة ونشر رسالته التي تمّت الموافقة عليها بعد إجراء التعديلات اللازمة.
7ـ فسح المجال أمام الباحث؛ لنشر مقال عن رسالته في مجلة (الإصلاح الحسيني) الفصلية المتخصِّصة في النهضة الحسينية التي تصدرها المؤسَّسة.
8 ـ العمل على تلخيص الرسائل الجامعية، ورفد الموقع الإلكتروني التابع للمؤسَّسة بها، ومن ثَمَّ طباعتها تحت عنوان: دليل الرسائل والأطاريح الجامعية المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة.
هذه الأُطروحة: مشهدية الشعائر الحسينية عند العرب والإيرانيين
تعتبر الشعائر الحسينية الدليل الهادي إلى أهداف ومبادئ وقيم النهضة الحسينية، فتلك الشعائر هي التي تحافظ على شعلة الهداية وهاجة منيرة متلألئة على مرّ العصور والأزمان.
تلك الشعلة التي أوقدها الإمام الحسين× بتضحياته وتضحيات أهل بيته وأصحابه، وهي آخر مشعل هداية للبشرية، فهي دين الإسلام الذي جاء به خير الأنام.
هذه الشعائر وبما تحمل من رسائل، تعرّضت لمختلف التحديات من قبل حكّام الجور، من المنع وقتل من يقيمها أو سجنه أو تشريده وما إلى ذلك، ولكنها كالذهب الأحمر كلما ضربته النار ازداد حمرة وجلاءً، فازدادت تلك الشعائر وتنوّعت وانتشرت واختلفت بعادات وتقاليد وعقائد وأفكار مختلف المجتمعات فعمّ بعضها واختص آخر، ووجدت مشتركات وتوافقات في إجراء بعضها.
وهذا ما سلّط الباحث عليه الضوء في أطروحته هذه، وخصص بحثه عند العرب والإيرانيين، مؤكّداً على شعيرة المسرح الحسيني وتاريخه وتأثيره، حيث إنّ لمسألة العرض المسرحي أهمية بالغة خصوصاً في الأزمان المتأخرة؛ كونه يمثّل ثقافة وحضارة إنسانية عامّة، وأصبح من موارد تباهي وتفاخر الأمم.
وفي الختام نسأل الله تعالى للمؤلِّف دوام السَّداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلمية في
مؤسسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
مقدمة قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
بسم الله الرحمن الرحيم
له الحمد جلّ شأنه وصلاته وسلامه على نبيه وآله الأطهار وبعد...
إنَّ لقتل الإمام الحسين× حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد ابداً، حقيقة تنبَّأت بها عقيلة الهاشميين يوم استُشهد أخوها ابن النبي وسيد شباب أهل الجنة، وقد صدقتْ بنتُ النبي’؛ فكان ما اخبرتْ به، واستعرت تلك الحرارة وتوهَّجت وتعاظم أمرها في قلب كلِّ من هو في دائرة التكامل الإنساني فضلاً عمن هو في دائرة الولاية، فكانت المادة الاولية لحالة التلاحم مع النهضة الحسينية، والسبب المباشر لإدامتها وتفعيلها، وانعكست تلك الحرارة المتأجِّجة في قلوب المؤمنين في مظاهر وفعاليات مثَّلتْ بمرور الزمن شعائر تحمل تلك النهضة رسالة لها، وتستمدُّ من تلك الحرارة طاقة لها، وبالمقابل أصبح لتلك الشعائر دورٌ مؤثِّرٌ في إدامة تلك الحرارة وإبقائها فاعلة موثّرة متأجِّجة.
وقد انطلقت تلك الشعائر المقدَّسة ـ كما هو ثابت ومعروف من نفس الأرض التي سُقيت بذلك الدم الطاهر لسيِّد شباب أهل الجنة، فمنها كانت البداية، ومنها انتشرت إلى باقي البلدان والأمصار ـ كما في كلِّ بداية أنَّها كانت متواضعة ومحدّدة ـ وبمرور الزمن أخذت تتّسع وتتعاظم وتتنوَّع بتنوَّع الثقافات والعادات التي تحكم القائمين عليها، فانعكس ذلك التنوُّع والانتشار على الشعائر قوةً وتاثيراً ودواماً.
وقد واجهت هذه الشعائر ـ كما هو متوقَّع ـ المنع والاعتراض من نفس الخطِّ المنحرف الذي ارتكب جريمة القتل النكراء؛ فإنَّ السبب الذي دفعه لارتكاب جريمته هو ذاته الذي يدفعه لمنع إحيائها، وقد تفاوتت درجة المنع هذه والمحاربة والتشويه شدةً وضعفاً باختلاف الزمن، واختلاف التيارات الفكرية الحاكمة، وتبعاً لذلك تفاوتت مظاهر العزاء الحسيني شدةً وضعفاً وتنوُّعاً وانتشاراً.
هذا الموضوع الذي أشرنا إليها تناولته أقلام عديدة توثيقاً وتوصيفاً وتحليلاً لجميع تلك الأبعاد أو لبعضها، وبمستويات مختلفة، وكان من تلك الدراسات القيِّمة التي تناولت هذا الموضوع رسالة جامعية سعت إلى بحث الموضوع بجدية وإسهاب ونَفَس علمي أكاديمي، وروح منفتحة على الدليل والتوثيق العلميين الرصينين؛ فكان ذلك وراء اختيارها من قبل اللجنة العلمية في قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسَّسة وارث الانبياء ليقدِّمها للقرُّاء الكرام.
وقد جاءت هذه الرسالة بعنوان: (مشهديَّة الشعائر الحسينية عند العرب والإيرانيين) وتضمَّنت بابين انتضم كلٌّ منهما في عدة فصول، فتمحورت فصول الباب الأوّل حول المواضيع التالية: الأوّل في بحوث تمهيدية، والثاني في العزاء الحسيني في العراق وباقي البلدان العربية، والثالث في العزاء الحسيني في إيران، وختمه بفصل تناول فيه أوجه التأثير المتبادل في العزاء بين العراق وإيران. وأمَّا الباب الثاني فتموضعت فصوله في العناوين التالية: الأوّل في بداية عروض التعزية في إيران، والثاني دراسة مقارنة لثلاث مسرحيَّات عاشورائية، والثالث نظرة إلى مسرحية تعزية عرس القاسم، وفي النهاية وشّح الأطروحة بخاتمة تناول فيها أهمَّ الموضوعات التي بحثها وأهمَّ النتائج التي توصَّل إليها، وكان الجديد من الأبحاث التي عرضها الكاتب، وسعى في متابعتها ووضعها في قالَب علمي قدراً لافتاً وجديراً بالمطالعة والإهتمام.
وقد أجرت اللجنة العلمية في القِسْم بعض التعديلات اللازمة على الأطروحة، بما ينسجم والمعايير التي وضعتها لكتابة الرسائل والأطاريح الجامعية بدءاً بعنوان الأطروحة الذي كان (مشهدية التعزية عند العرب والفرس)؛ حيث وجدتْهُ أخصّ من محتوى الأطروحة؛ إذ ما تناولته من عموم الشعائر الحسينية، والتعزية لا يمثِّل إلّا مفردة منها، وحديثها عن الشعائر عند الإيرانين بجميع قومياتهم والفرس لا تمثِّل إلا واحدة من تلك القوميات، ولهذا أبدلتْهُ اللجنة العلمية بالعنوان المثبَّت الآن على الكتاب وهو (مشهدية الشعائر الحسينية عند العرب والإيرانيين)، فجاءت كلمة (الشعائر) بدلاً من كلمة (التعزية) وكلمة (الإيرانيين) بدلاً من كلمة (الفرس)؛ ليكون العنوان منطبقاً على محتوى الأطروحة.
وتعني كلمة (مشهدية) هنا مطلق الشعائر، وما يشاهد حسّاً، ولا تعني المعنى المسرحي المتداول. وقد جرى ذلك التعديل بالتنسيق مع الكاتب وبموافقته، وقد أجرينا ـ زيادة على ذلك ـ تغييراً على مستوى بعض عناوين الأبحاث ومواضعها في الأطروحة، واستحداث بعض العناوين الجديدة، وبعض الحذف والإضافة اللازمة لبعض المواضيع وبالمقدار الذي لا يؤثِّر على هوية الأطروحة ومحتواها.
وفي الأخير نسأل الله تعالى ان نكون قد وفِّقنا في الاختيار وفي التعديل الذي أجريناه، وأن نكون قد قدَّمنا للفكر الحسيني الأصيل نتاجاً علمياً نافعاً، ومنه تعالى نستمدُّ العون والتوفيق.
اللجنة العلمية في
قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
في مؤسّسة وارث الانبياء
تقول الدكتورة بنت الشاطئ:
«وما أحسب أنّ التاريخ قد عرف حزناً كهذا؛ طال أمده حتى استمرّ بضعة عشر قرناً دون أن يفتر، فمراثي شهداء كربلاء هي الأناشيد التي يترنّم بها الشيعة في عيد حزنهم يوم عاشوراء في كلّ عام، ويتحدّون الزمن أن يغيّبها في متاهة النسيان». وتضيف: «وكذلك كانت زينب عقيلة بني هاشم في تاريخ الإسلام، وتاريخ الإنسانيّة بطلة استطاعت أن تثأر لأخيها الشهيد، وأن تسلّط معاول الهدم على دولة بني أميّة وأن تغيّر مجرى التاريخ».
بسم الله الرحمن الرحيم
يقيم الشيعة في إيران والعراق والبلدان العربيّة والإسلاميّة مراسم العزاء والحِداد في الأيّام العشرة الأولى من شهر محرّم من كلّ عام، إحياءً لذكرى استشهاد الإمام الحسين×. وتُقام مجالس العزاء في المساجد والحسينيّات والتكايا، كما تخرج مواكب العَزاء إلى الشوارع والميادين في البلدان العربيّة والإسلاميّة. ويُعرَض الشبيه في مدن عديدة ومنها كربلاء والنجف والكاظمية وفي إيران ولبنان والهند الذي يجسِّد معركة كربلاء، واستشهاد الإمام الحسين× علي يد جيش يزيد بن معاوية، وأخذ أهل بيته أسرى إلى الكوفة والشام.
يأتي الملايين من الشيعة كلَّ عام من مختلف أقطار العالم إلى كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين؛ لتجديد البيعة مع إمامهم، ورجاء الفوز بثواب زيارته. ويتأثّر كثيرون من محبّي أهل البيت^ بقراءة المقَاتِل والتعازي العاشورائيّة ويفقد البعضهم الوعيَ عند سماعهم ما جرى الإمام الحسين وأهل بيته من قتل وذبح وأذى، بل إنّ الكثيرين منهم يقومون بتعذيب أنفسهم والإضرار بها بآلات وأدوات جارحة ممّا جعل العديد من العلماء ينهَون عنها.
تُقام في إيران إضافة إلى طقوس العزاء والحِداد، عروض التعزية والشَّبيه علي المسرح، حيث يؤدّي الممثّلون أدوارَ الإمام الحسين× واصحابه وأهل بيته، وقادة جيش يزيد في واقعة كربلاء، و الذی یُطلَق علیه اسم مسرح التعزیة.
لا شكّ أنّ المجالس ومواكب العزاء بدأت بسيطة، ولكنّها اكتسبت زخماً كبيراً على مرّ الأزمان، بسبب مواجهة الشيعة للتحدّيات ومنها قيام الخلفاء الأمويّين والعبّاسيّين بقمع الشيعة خلال إقامتهم طقوس العزاء سواء في العراق أو في إيران وبلدان أخرى. فالتاريخ يشير إلى أنّ المعارضين لطقوس العزاء خلال الحكم الأمويّ والعبّاسي في العراق وإيران كانوا يقمعون أيّ تحرّك يظهر حزن الشيعة على الإمام الحسين×، أو بكاءهم عليه في ذكرى استشهاده. فالتاريخ يشهد ضراوة القمع ضدّ الشيعة لا لجرم ارتكبوه، بل بسبب إقامة مجالس العزاء على الإمام الحسين×. وكان الشيعة يقيمون مجالس العزاء في البيوت؛ خوفاً من السلطان والسلطات، بل وصل الأمر إلى أنَّ أمر المتوكِّل العبّاسيّ بهدم قبر الإمام الحسين×، وتسويته بالتراب واعتقال وقتل كلّ من يرونه يزور قبر الإمام الحسين، كما أنّ التاريخ يذكر لنا كيف أنّ البربهاري الحنفيّ في بغداد أمر بقتل نائحة واسمها خِلْب كانت تنوح على الإمام الحسين×، وقد قُطع لسان نائح أيضاً بسبب رثائه الإمام الحسين بن علي×.
إنَّ سبب اختياري لموضوع (مشهدية الشعائر الحسينية عند العرب والإيرانيين) هو عدم تطرُّق الباحثين لهذا الموضوع علي شكل بحث أو كتاب، لأنَّ هذا البحث هو دراسة مقارنة بين الشعائر الحسينية في العراق وإيران، وما أضافه الإيرانيون من ممارسات تتعلَّق بالشعائر الحسينية، ولا سيما مسرح التعزية في إيران.
إنّ موضوع (مسرح التعزية في إيران) موضوع جديد في العالم العربيّ، لم تتناوله الدراسات الجامعيّة حتى الآن، فهناك دراسات قليلة عن المسرح في إيران ولم تنشر دراسات مستفيضة عنه. فدراسة مسرح التعزية في إيران تجعلنا نتناول موضوعاً قلّما تناوله الباحثون العرب وهو عرض واقعة كربلاء على المسرح وتمثيل مقتل الإمام الحسين أمام المشاهدين.
أثارت العروضُ المسرحيّة التي تقام في إيران انتباهَ الباحثين الغربيّين، لأنّها كانت الوحيدة والجادّة في العالَم الإسلاميّ كما يصفها الخبير الأمريكيّ من أصل بولنديّ المختصّ في عروض التعزية، بيتر تشلكوفسكي([8]).
لقد كان استشهاد الإمام الحسين× وقضيّته الخالدة موضوعاً أدبيّاً أثرى الأدَبَين العربيّ والفارسيّ إثراءً لا نظير له منذ استشهاده وحتّى يومنا هذا، وقد جذبت قضيّة الإمام الحسين× المسلمين وغير المسلمين والشعراء والمفكّرين، ونشاهد الشعراء العرب والإيرانيين قد نظموا القصائد منذ استشهاده× وحتى وقتنا الحاضر، ورثوا الإمام الحسين وأهل بيته وبكَوه، وتحمّل العديد منهم الاضطهاد والقتل والتشرُّد على أيدي الحكّام الأمويّين والعبّاسيّين وغيرهم.
كان لواقعة كربلاء الأثر الكبير في ظهور طبقة من الكتّاب والخطباء والشعراء، والشعراء الشعبيّين، والرواديد والنائحين، والرسّامين، والفنّانين المسرحيّين، تناولوا واقعة عاشوراء كلٌّ حسب موهبته من الكتابة والخطابة والشعر والرسم والتمثيل.
ضمَّت الأطروحة بابين، تناولتُ في الباب الأوّل (العزاء الحسيني عند العرب والإيرانيين) وقسّمتُ الباب إلى ثلاثة فصول، الأوّل: العزاء الحسيني في العراق وباقي الدول العربية، والفصل الثاني: العزاء الحسيني في إيران، والفصل الثالث: التأثير المتبادل بين العرب والإيرانيين في إقامة طقوس العزاء، وتناولتُ في الباب الثاني (مسرح التعزية في إيران)، وقسّمتُ الباب الثاني إلى ثلاثة فصول: الأوّل: كيف عرف الإيرانيّون المسرح؟ والفصل الثاني: تناولتُ دراسة مقارنة لثلاث مسرحيّات عاشورائيّة، ودرستُ في الفصل الثالث: تعزية عرس القاسم. كما جاءت في نهاية الأطروحة الخاتمة، والمصادر والمراجع.
اتبع الباحث المنهج الوصفی التحلیلی فی دراسة العزاء الحسینی فی العراق وإيران.
وکان علی الباحث ان یطَّلع علی المصادر الفارسیة والعربیة وکتب المستشرقین التی کُتِبت بالإنجلیزیة واللغات الأخری، سواء التاريخیة، أوالادبیة، أوالدینیة الموجودة فی مکتبات إيران والعراق ولبنان؛ وهذا ما جعل کتابة الأطروحة تأخذ وقتاً طویلاً تجاوز الخمس سنوات.
ولابدَّ من الإشارة إلي أنَّ کتباً کثیرة تناولت العزاء الحسینی عند العرب والإيرانیین ألَّفها عرب وإيرانیون وأجانب؛ منها علی سبیل المثال کتاب المناحة علی الحسین بن علی، تألیف السید صالح الشهرستانی، والمجالس السَّنیَّة فی العترة النبویة، تألیف السید محسن الأمین العاملی، ودائرة المعارف الحسینیة، لمحمد صادق الکرباسی، وطوفان البکاء للجوهری المروی، و(روضة الشهداء) لملَّا حسین واعظ کاشفی.کما تناول کتَّاب إيرانیون عروض التعزیة فی إيران منهم: ید الله آغا عباسی لتألیفه کتاب: (دائرة معارف العرض المسرحی فی إيران)، وبهرام بیضائی لکتابه: (العرض المسرحي فی إيران)، وعلی بلوکباشی لکتابه (قراءة التعزیة، حدیث المصائب القدسیة)، ولاله تقیان لکتابها (التعزیة والمسرح فی إيران).
إنَّ من أهمِّ النتائج التي توصَّلت إليها الدراسة أنَّ الشعائر الحسينية بدأت في العراق بعد استشهاد الإمام الحسين×، وانتقلت إلى إيران وسار الإيرانيون على خُطَى العراقيين في تسيير مواكب العزاء، والشَّبيه والتمثیل، وإقامة مجالس العزاء في التكايا والحسينيات التي بُنِيت لإقامة مجالس العزاء على الحسين×.
کما أنَّ الإيرانیین نقلوا الشعائر الحسينية من الساحات العامَّة والشوارع إلی المسارح التی أُقیمت خصِّیصا لعروض التعزیة وعُرفت فیما بعد بمسرح التعزیة، كما أنَّهم قاموا بإنتاج أفلام وثائقیه عن واقعة عاشوراء عُرضت فی إيران وفی الغرب وکان لها الأثر الکبیر فی التعریف بثورة الإمام الحسین× ضدَّ قوی الظلم.
ومن بين النتائج التي توصَّلت إليها الدراسة أنَّ الإيرانيين والعراقيين تأثَّر بعضهم بالبعض الآخر في إقامة الشعائر الحسينية بسبب الزيارات المتبادلة للشعبين المسلمين، وكانت طقوس العزاء في البلدين شبيهة بعضها بالبعض الآخر، ومنها إقامة مجالس العزاء، والمواكب، وحمل المشاعل، وحرق الخيام، وركضة طويريج وطقوس عرس القاسم، وحمل التوابيت، وحمل صور أئمة أهل البيت^ والسير مشياً على الأقدام.
كما وسلَّطنا الضوء على دور الشعراء في رفد الشعائر الحسينية بالشعر والنثر، وما لهذا الدور من تأثير كبير في إحياء العزاء الحسيني، وقد ظهر ذلك في محطَّات عديدة من الرسالة وبالخصوص في الباب الثاني المتعلَّق بالمسرح الحسيني.
هذا البحث الذي بين يدي القُرَّاء الكرام ـ وكما أشرنا إلى ذلك قبل قليل ـ هو أطروحة دكتوراه قُدِّمت إلى الجامعة الإسلامية في لبنان، نال الباحث عليها درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها بدرجة جيد جدّاً.
ومما تفتخر به الرسالة أنَّها حازت على عبارات تقريض قيِّمة جاد بها بعض الأساتذة المشرفين عليها، منهم أستاذ الأدب العربي في الجامعة الإسلامية الأستاذ الدكتور وجيه فانوس : «إنَّها تناولت موضوعا جذّاباً لم تتناوله أقلام من قبلُ وهو سِفر جليل جداً، ولابدَّ أن نعترف بسموِّ اللغة».
وكذا الأستاذ الدكتور سليمان حسيكي: «إنَّ موضوع الرسالة جديد، أفاد الطالب من جهود السابقين واتخذها لبنات لبناء اطروحته».
واعتبر الأستاذ الدكتور محمد شُقير: «أنَّ موضوع الأطروحة ذو أهميَّة يستحقُّ الدراسة، من أكثر من جهة، و جهد كبير بذله الباحث».
ومما حضيت الرسالة به من توفيق ـ أنَّ قسم الرسائل الجامعية في مؤسَّسة وارث الانبياء الذي يهتمُّ بمتابعة الرسائل التي كُتِبت في موضوع الإمام الحسين× ونهضته المباركة، ويختار منها ما هو مؤهَّل للنشر بعد إجراء ما يلزم من تعديل وتقويم وترتيب، وِفق معايير علمية يعتمدها ـ أن كانت رسالتي من تلك الرسائل التي حظيت بهذ الاختيار، وفي ضوئه قامت اللجنة العلمية في القسم بإجراء مايلزم عليها من تعديل واعدادها للنشر، ومن هنا لا يسعني إلا أن اتقدَّم بالشكر الجزيل، والثناء العظيم للأساتذه أعضاء اللجنة العلمية لقسم الرسائل الجامعية في مؤسَّسة وارث الأنبياء على صنيعم وفضلهم، وأن يجعله ذخراً لهم يوم لاينفع مالٌ ولا بنونَ إنَّه سميع مجيب.
شاكر كسرائيالأوّل: الحسيني عند العرب والإيرانيين
الفصل الاول
العزاء الحسيني
عند العرب والإيرانيين
وتضمَّن الفصول التالية :
الفصل الأوّل: بحوث تمهيدية.
الفصل الثاني: العزاء الحسيني عند العرب.
الفصل الثالث: العزاء الحسيني عند الإيرانيين.
الفصل الرابع: التأثير المتبادل بين العرب والإيرانيين في إقامة العزاء الحسييني.
الفصل الاول
أولاً: العزاء الحسيني في الّلغة والاصطلاح
العزاء: الصبر عن كلِّ ما فقدت، وقِيل: حسنه عَزِيَ يَعزَى عَزاءً ـ ممدود ـ فهو عَز، ويُقال: إنَّه لَعزِيٌّ صبورٌ إذا كان حَسَن العزَاء على المصائب، وعَزَّاهُ تعزيَة ـ على الحذف والعوض ـ فتَعَزَّى، وقيل: عَزَّيته من باب تَظَنَّيت، وقد ذُكر تعليلُه في موضعه، وتقول: عَزَّيتُ فلانا أُعزِّيه تَعْزِيةً، أي أسيتُه وضربت له الأسَى، وأمرته بالعَزَاء فتعزَّى تعزِّيا، أي تصبُّر تصبُّراً. وتَعَازَى القوم: عَزَّى بعضهم بعضاً ـ عن ابن جني . والتعَزُوَة: العَزَاء ـ حكاه ابن جني عن أبي زيد ـ اسم لا مصدر؛ لأنَّ تفعلةً ليست من أبنية المصادر، والواو هاهنا ياء، وإنَّما انقلبت للضمَّة قبلها كما قالوا الفتُوَّة([9]).
وفی کتاب (لغت نامه) لمولِّفه العلَّامه دهخدا فإنَّ کلمة عزاداری: العزاء تعنی: إقامة العزاء و البکاء والمصائب وإقامة مراسم العزاء([10]).
وكلمة التعزية تستخدم فی إيران وتعنی إقامة مجالس العزاء على الإمام الحسين ابن علي× في التكايا والحسينيّات والمساجد والبيوت، وكذلك خروج مواكب العزاء إلى الشوارع. كما أنّ التعزية تعني إقامة عروض التعزية على المسرح وتمثيل واقعة كربلاء، واستشهاد الإمام الحسين ومصائب أهل بيته([11]).
كلمة التعزية متداولة بين المسلمين الشيعة في إيران والعراق ولبنان ودول الخليج، وشبه القارة الهنديّة، وأفغانستان والعديد من البلدان الأوروبيّة التي يسكنها الشيعة، ولها معانٍ ومفاهيم متعدّدة منها العزاء، والحزن، وإقامة المآتم ومجالس العزاء، والنواح والندب على الحسين بن عليّ.
وتعني كلمة التعزية عند الإيرانيّين، إضافة إلى إقامة مجالس العزاء على الحسين ابن عليّ، وخروج مواكب العزاء، عرض وقائع كربلاء على المسرح، وما حدث للحسين وأهل بيته من قتل وسبي. ويسمّى بالفارسيّة نمايش تعزيه [إقامة عروض التعزية]. كما تعني التعزية إقامة عرض تمثيليّ، مسرحيّ، عن واقعة كربلاء، أو ما يُسمّى بالشَّبيه على أرضٍ أو مسرحٍ يصوّر ما جرى في كربلاء للحسين وأصحابه وأهل بيته.
ونظراً لقلّة الكتب التي كتبها كتّاب إيرانيّون عن التعزية في إيران طوال العصور الماضية، فإنّ مذكّرات السيّاح الأوروبيّين والدبلوماسيّين المعتمدين لدى بلاط الملوك الصفويّين والقاجاريّين، أصبحت مصدراً رئيسيّاً لدراسات الإيرانيّين عن التعزية. علماً أنّ كتباً قليلة كتبها كتّاب إيرانيّون في العصرين الصفويّ والقاجاريّ عن أوضاع إيران في هذين العصرين مشيرين إلى مراسم التعزية، من دون الدخول في التفاصيل، ومن أبرز هذه الكتب كتاب (تاريخ عالم آراي عبّاسي) [تاريخ العالم في عصر الشاه عبّاس الصفويّ] لمؤلّفه اسكندر بيك منشي الذي کان أمين السر لدى الشاه عبّاس الصفويّ، وتوفّی في العام 1629. تحدّث المؤلّف عن عصر الشاه عبّاس الصفويّ وأشار إلى إقامة مراسم العزاء في هذا العصر.
وهناك كتاب آخر بعنوان: (شرح زندگانی من) تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجاریه [سيرة حیاتي، التاریخ الاجتماعيّ والإداريّ في العصر القاجاريّ] للكاتب عبد الله المستوفي وهو يتحدّث عن العصر القاجاريّ ومشهديّة التعزية في هذا العصر.
نقل السيّاح الغربيّون والمبعوثون الأجانب في بلاط ملوك الصفويّين والقاجاريّين مشاهد التعزية، بكلّ تفاصيلها إلى القراء الأوروبيّين في كتب الرحلات التي كتبوها في القرن السابع عشر وما بعده وتُرجِمت هذه الكتب إلي الفارسيّة، ويعتمد عليها الكتّاب والباحثون الإيرانيّون في بحوثهم وكتاباتهم عن التعزية في عاشوراء.
ثانياً: العزاء الحسيني والحظارات القديمة
يربط العديد من الباحثين بين العزاء على الإمام الحسين× ووقائع في التاريخ القديم تخلّلتها التعازي والبكاء والمآتم. فطقوس الموت والحزن والبكاء كانت معروفة في المجتمعات والأديان الشرقيّة القديمة، ولا سيّما في إيران وبلاد مابين النهرين.
فهناك وقائع في التاريخ الإيرانيّ القديم تتحدّث عن مقتل 23 من إخوة وأولاد البطل الإيرانيّ غتشاسب، ومنهم زرير الذي يقوم ابنه بالإنتقام لدم أبيه، ويقف إلى جانب جسد والده ويبكي عليه، ويردّد كلاماً حزيناً في رثائه([12]).
تذكر المصادر الإيرانيّة أنّ طقوس العزاء والنواح جرت على البطل الأسطوري الإيرانيّ سياوش وهو ابن كاووس، وقد قُتِل إثر مؤامرة حِيكت له، ويُعدّ سياوش بطلاً خلّده التاريخ القديم، ولا يزال يُعرَف لدى الفرس بالبطل الأسطوريّ، فهو أمير حِيكت له مؤامرةٌ ووُجّهت له تُهمٌ مختلفة فهرب من إيران وتوجّه إلى أرض طوران، وهناك قُتل على يد أفراسياب. ويُوصَف سياوش بأنّه قُتل مظلوماً، وكان الإيرانيّون القدماء يبكون في ذكرى مقتله ويحزنون عليه. ويقول النرشخي (286 ـ 348هـ/899 ـ 959م) صاحب كتاب (تاريخ بخارى) إنّ لدى أهل بخارى أناشيد عجيبة؛ حزناً على مقتل سياوش. والمغنّون يصفون هذه الأناشيد بأنّها (عداوة سياوش) ويقول بأنّ ذلك حدث قبل ثلاثة الآف سنة ([13]).
ويُلاحَظ بأنّ رسوماً حائطيّة تعود إلى ثلاثة قرون قبل الميلاد، وُجدت في مدينة سغدي بنجیکتت الواقعة في سهل زرافشان على بعد 68 كيلومتراً من سمرقند. في هذه الرسوم نرى نساءً يضربْنَ رؤوسهنَّ ويلطمْنَ صدورهنَّ، كما نرى نساءً أخريات يحملْنَ تابوت شاب، هو على ما يبدو سياوش. فالأرجح أنّ هذه الرسوم تصوِّر مأتم سياوش([14]). ويرى الكاتب الإيرانيّ يعقوب آجند بأنّ هناك تشابهاً بين مأتم سياوش وعزاء الإمام الحسين. فسياوش قُتل مظلوماً، والحسين قُتل مظلوماً أيضاً، وسیاوش کان یعرف مصیره والحسین کان یخبر الآخرین بمصیره([15]).
كما تذكر لنا كتب التاريخ القديمة بأنّ الإيرانيّين كانوا يحزنون على شروين أحد ملوك فرقة خرم دینان التي ظهرت بعد مقتل أبي مسلم الخراسانيّ في إيران في العام 192هـ والتي ثارت ضدّ العرب وكانوا یقرأون التعازي حداداً وحزناً علیه. وقام بعض المستشرقين ومنهم إيردمنس بالمقارنة بين طقوس العزاء على الحسين التي كانت تجري في بداية القرن التاسع عشر في إيران وبين طقوس الموت والبكاء على الإله تموز (أدونيس) التي كانت تقام سنويّاً في سومر وبابل([16]).
ويقول إيردمنس بأنّ الاحتفالات التي كانت تجري في شارع الموكب ببابل من أجل تموز(أدونيس) تلقي ضوءاً يساعدنا على مقارنتها بما كان يجري في إيران في القرن التاسع عشر أيام عاشوراء من بكاءٍ ونواح وتراتيل حزينة. واستَشهد إيردمنس برمز آخر من رموز الاحتفالات بعاشوراء هو (كف العبّاس) التي ترفع في مواكب العزاء على الحسين والتي تدلّ على تشابه واضح مع طقوس بابلية وكريتيّة وكذلك يهوديّة قديمة، حيث ترمز الكفّ إلى الخصوبة، مثلما ترمز إلى الوعي بعودة تموز ثانية، على الرغم من موته، في ربيع العام التالي والتقائه بحبيبته عشتار إلهة الخصوبة. وقد دعم إيردمنس فرضيّته بأدلّة لغويّة وهي أنّ اسم تمّوز مركّب في اللغة المسماريّة البابليّة القديمة من معنيين هما: (يد) و(حبوب)([17])، ولكن اليد المفتوحة التي تُرفَع في رؤوس الأعلام والرايات في مواكب العزاء الحسينيّ إنّما ترمز إلى (كفّ العبّاس) التي قُطعت خلال المبارزة في معركة الطف بكربلاء. وهي كفّ غالباً ما تكون مصنوعة من النحاس، وتعبِّر عن تضحية العبّاس بيديه من أجل جلب الماء من نهر الفرات إلى طفل الحسين الرضيع بعد أن قطع جيش ابن زياد الماء عن الحسين وأصحابه.
ويرى الدكتور كامل مصطفى الشبيبي «بأنّ مراسم العزاء عند الشيعة بدأت في عهد البويهيّين في العام 352هـ، وكان العراقيّون القدماء قد أقاموا العزاء المنظّم وتجلّى ذلك في ملحمة جلجامش التي تعود إلى ثلاثة الآف سنة قبل الميلاد»([18]).
يرى عدد من الباحثين الإيرانيّين أنّ التعزية في إيران متأثِّرة بأساطير ومسرحيّات بين النهرين، وذلك بسبب وجودشبه ظاهري بين التعزية في إيران، والأساطير والمسرحيّات العائدة إلى بلاد ما بين النهرين مثل تموز وجلجامش([19]). ويرى الباحث الإيرانيّ إحسان يار شاطر أنّ هناك وجوه شَبَه بين عزاء سياوش وطقوس العزاء على الحسين([20]).
نعتقد بأنّ مجرد وجود شَبَه بين عزاء سياوش وعزاء الإمام الحسين، لا يعني أنّ الإيرانيّين اقتبسوا مراسم وطقوس العزاء من الإيرانيّين القدماء وخاصّة عزاء سياوش، لأنّ عزاء الحسين يقوم بإحيائه المسلمون سواء في إيران أو في البلدان العربيّة والإسلاميّة، ولذلك لا يمكن أن نقول بأنّ الإيرانيّين تأثّروا بطقوس التعزية الإيرانيّة القديمة، ولكن ليس مستبعداً انتقال طقوس عزاء الحسين من العراق إلى إيران أي أنّ العراقيّين بدأوا مراسم وطقوس التعزية على الحسين، ومنها انتقلت الطقوس إلى الإيرانيّين بسبب تبادل الزيارات بين الطرفين.
حاول العديد من الباحثين إقامة جسر بين مراسم العزاء لدى المسيحيّين والمسلمين، ويعتقد آدم متز بأنّ الكثير ممّا قيل في جمعة آلام المسيح من القضايا التي تثير المشاعر قد دخلت إلى عاشوراء([21]). كلام متز يعني أنّ المسلمین قلّدوا الغربيّين في البكاء والحزن والرثاء وكأنّ الإنسان الشرقيّ مسيّر وليس مخيّراً حتى إنّه يقلّد الغربيّين في الأتراح وذرف الدموع والأحزان.
لا يحتاج الإنسان إلى تقليد الآخرين عندما يواجه منظراً محزناً أو عندما يفقد عزيزاً عليه، فإنّه ينفعل ويحزن وتنهمر دموعه من دون أن يمتلك نفسه، فالحسين قُتل في كربلاء مع جميع أصحابه وأولاده، وقد ذُبحوا ونُصبت رؤوسهم على الرماح وأُسر أهله وعياله، وهذا ما يستدعي من محبيه وشيعته البكاء والحزن على ما آل اليه مصيره. إنّ مراسم العزاء الحسينيّ هي في الحقيقة تقاليد شعبيّة عربيّة إسلاميّة، استمدّت شرعيّتها واستمرّاريّتها في الزمان والمكان من حقيقة تاريخيّة هي مقتل الإمام الحسين في واقعة الطفِّ بكربلاء، تلك الذكرى الأليمة التي ما زالت آثارها حيّة في ذاكرة المسلمين. كما أنّ الحزن والبكاء هي عادات معروفة في المجتمعات الشرقيّة منذ أقدم العصور، وفي جميع الأديان السماويّة والحضارات القديمة؛ لأنّها من طبيعة الشرقيّين الذين هم أكثر من غيرهم من الشعوب انفعالاً وحماساً. وقد نشأ التشيّع وتطوّر في بيئة وأرض عربيّة ـ شرقيّة هي العراق([22]).
في العاشر من محرّم 61 للهجرة (التاسع من أكتوبر ـ تشرين الأوّل 680م)، استشهد الإمام الحسين× واثنين وسبعين من أولاده وأهل بيته وأصحابه في أرض كربلاء، في معركة غير متكافئة مع الجيش الأمويّ المؤلَّف من ثلاثين ألف مقاتل، حاصروه وقطعوا عنه الماء، وقتلوه هو وأصحابه وجزّوا رؤوسهم ونصبوها على الرماح، وأرسلوها إلى عبيد الله بن زياد والي الكوفة، ومنها إلى يزيد بن معاوية في الشام، كما أسروا أهل بيته وأخذوهم إلى الكوفة والشام، ومنها إلى المدينة.
«لم يعرف التاريخ هزيمة كان لها من الأثر لصالح المهزومين كما كان لدم الحسين، فلقد أثار مقتله ثورة التوابين وخروج المختار، ولم ينقض ذلك حتّى أفضى الأمر إلى ثورات أخرى إلى أن زالت الدولة الأمويّة بعد أن أصبحت ثارات الحسين هي الصرخة المدوّية؛ لتدّكَّ العروش وتزيل الدول، فقام بها ملك العبّاسيّين ثم الفاطميّين واستظلّ بها الملوك والأمراء بين العرب والفرس والروم»([23]).
تحمّل أهل بيت الحسين أنواع العذاب بعد استشهاد الحسين بن علي×، ولا سيّما عندما أُخذوا أسرى إلى الشام، «فعندما أُدخلوا على يزيد بن معاوية في الشام، وهو بين حاشيته وأعيانها ووجهائها وهم مقرَّنون بالحبال والإمام زين العابدين مغلول، قال الإمام علي بن الحسين× مخاطباً يزيد: (أنشدك الله ما ظنّك برسول الله لو رآنا على هذه الصفة؟) فلم يبقَ في القوم أحدٌ إلّا وبكى. فأمر يزيد بالحبال فقُطعت، وأمر بفكّ الغلّ عن الإمام زين العابدين. ثمّ وُضع رأس الحسين بين يدي يزيد الذي أجلس النساء خلفه لئلا ينظرن إليه، فجعلت فاطمة وسكينة بنتا الإمام الحسين يتطاولان لينظرا الرأس، وجعل يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس. فلمّا رأينَ الرأسَ صحنَ، فصاحت نساء يزيد، وولولت بنات معاوية، فقالت فاطمة: (أبنات رسول الله سبايا يا يزيد؟) فبكى الناس، وبكى أهل داره حتّى علت الأصوات»([24]).
أمّا زينب بنت علي فإنّها لما رأت الرأسَ أهوت إلى جيبها فشقَّته، ثمّ نادت بصوت حزين يقرّح القلوب: «يا حسيناه، يا حبيب رسول الله، يا ابن مكّة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، يا ابن بنت المصطفى»... قال الراوي: «فأبكت والله كلّ من كان حاضراً بالمجلس ويزيد ساكت، ثم جعلت امرأة من بني هاشم كانت في دار يزيد تندب الحسين وتنادي: (يا حبيباً، يا سيد أهل بيتنا، يا ابن محمّداه، يا ربيع الأرامل واليتامى، يا قتيل أولاد الأدعياء)، فأبكت كلّ من سمعها. وكان في السبايا الرباب بنت امرئ القيس زوجة الحسين وهي اُمّ سكينة بنت الحسين وأمّ عبد الله الرضيع المقتول بكربلاء، فأخذت الرباب الرأس ووضعته في حجرها.. ثمّ أقيمت المناحة ثلاث أيام وصالاً...»([25]).
كانت هذه أوّل مناحة عامّة على الحسين وأهله وصحبه تقام في الشام، إذ إنّ الروايات تفيد بأنّ يزيد أمر بأن تقام للسبايا والأسرى دار تتصل بداره، وكان هؤلاء مدّة مقامهم في أيامهم الحزينة بالشام ينوحون على الحسين في سرّهم وعلنهم. هذا ولم تكن بنات آل البيت والهاشميّات وحدهن الباكيات، بل واسَتْهُنّ نساء بني أميّة بدموعهنَّ، فلم تبقَ أمويّة إلّا وأخذت تبكي وتنوح على الحسين وسباياه([26]).
ولما رجع نساء الحسين× وعياله من الشام وبلغوا العراق، قالوا للدليل: مُرَّ بنا على طريق كربلاء. فوصلوا إلى موضع المصرع، فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري&([27]) وجماعة من بني هاشم ورجالاً من آل الرسول قد وردوا لزيارة قبر الحسين× فوافوا في وقت واحد، وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم وأقاموا المآتم المقرّحة للأكباد، واجتمعت إليهم نساء ذلك السواد، وأقاموا على ذلك أياماً. ثم انفصلوا من كربلاء طالبين المدينة([28]).
وصل أهل بيت الحسين إلى المدينة، فقد روى بشير بن حذلم مشهد أهل بيت الحسين في المدينة بقوله: «فلمّا قربنا منها (المدينة المنوّرة) نزل عليّ بن الحسين×، فحطّ رحله وضرب فسطاطه وأنزل نساءه. وقال: (يا بشير، رحم الله أباك لقد كان شاعراً، فهل تقدر على شيء منه؟) قلت: بلى يا ابن رسول الله، إنِّي شاعر. قال: (فادخلِ المدينة وأنعَ أبا عبد الله)». قال بشير، فركبتُ فرسي وركضتُ حتّى دخلتُ المدينة، فلمّا بلغتُ مسجد النبي|، رفعتُ صوتي بالبكاء، وأنشأت أقول:
|
يا أهلَ يثربَ لا مُقامَ لكم بها |
قال: ثم قلتُ: «هذا عليّ بن الحسين× مع عمّاته وأخواته قد حلّوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرّفكم مكانه»([29]).
قال: فما بقيت في المدينة مخدّرة ولا محجّبة إلا بَرَزْنَ من خدورهنّ، مكشوفة شعورهنّ، مخمشة وجوههنّ، ضاربات خدودهنّ، يدعون بالويل والثبور، فلم أرَ باكياً ولا باكية أكثر من ذلك اليوم، ولا يوماً أمرَّ على المسلمين منهُ بعد وفاة رسول الله|. وسمعتُ جارية تنوحُ على الحسين× وتقول:
|
نَعى سَيِّدي ناعٍ نَعاهُ فأوجَعا |
لما دخل أهل بيت الحسين المدينة، تلقّتهم امرأة من بنات عبد المطلب([31]) ناشرة شعرها، واضعة كفّها على رأسها تبكي وتقول:
|
ماذا تقولونَ إنْ قالَ النبيُّ لکُمْ ما كان هذا جزائي إذ نصحتُ لكُم |
تشير الدكتورة بنت الشاطئ إلى وصول سبايا أهل البيت من الشام إلى المدينة في العام 61هـ وتقول: «ضجّت المدينة بالبكاء، وهي تستقبل بقايا الرَكب الحسينيّ الذي ودّعته منذ أقلّ من شهر. وبرَزت النساء ـ كلّ النساء ـ صارخات باكيات، وخرَجت عقيلات بني هاشم من خدورهنّ حاسرات الوجوه، يندُبنَ في لوعة: واحسيناه، واحسيناه، ولم تبقَ في المدينة دار إلّا وبها مأتم، ولبَثَت مناحة الشهداء هناك قائمة أياماً وليالي، حتى جَفّت المآقي من طول ما سكبت من دمع، وحتى ضحلَ الحلق من طول ما أجهَدَها النواح»([37]).
وتستطرد الدكتورة بنت الشاطئ فتقول: وفي المدينة أقامت الرباب بنت امرئ القيس ـ زوجة الحسين المأتم عليه، وبكت النساء معها حتّى جفّت دموعها، ولما أعلَمَتها بعض جواريها بأنّ السُويق يُسيل الدمعة أمرَت أن يُصنع السويق، وقالت: إنّها تريد أن تقوى على البكاء، وقد خَطبها بعد الحسين الأشراف، فأبَت وقالت: ما كنتُ لأتخذ حِماً ـ أي أقارب الزوج:
|
والله لا أبتغي صهراً بصهركم حتى أغيّب بين الرمل والطين |
وهكذا بقيت الرباب سنة بعد الحسين، لم يُظلّها سقف بيت حتى بَليت وماتت([38]).
وذكر البرقي في المحاسن: «لما قُتل الحسين بن علي لبست نساء بني هاشم السواد والمسوح، وكنَّ لا يشتكين من حرّ ولا برد»([39]).
وبقيت عادة لبس السواد على الحسين حداداً حتى عصرنا الحاضر، واستمرّ الشيعة في النواح والندب وقراءة أشعار الرثاء لفقد الحسين وأهل بيته.
وذكر محسن الأمين في (المجالس السنيّة): «وكانت أمّ البنين وهي فاطمة بنت حزام الكلابيّة ـ أمّ العبّاس بن علي وأخوته: عبد الله، وجعفر، وعثمان، الذين قتلوا مع أخيهم الحسين يوم عاشوراء ـ أمّ هؤلاء الإخوة الأربعة ـ بعد قتلهم، تخرج كلّ يوم إلى البقيع في المدينة، وتحمل معها عبيد الله ابن ولدها العبّاس فتندب أولادها الأربعة خصوصاً أشجى ندبة وأحرقها، فيجتمع الناس يستمعون بكاءها وندبتها، فممّا كانت ترثي به قولها في أولادها الأربعة:
|
لا تدعيني ويكِ أمَّ البنينِ |
كما كانت تندب العبّاس بقولها:
|
يَا مَنْ رَأى العبّاس كرّ |
|
على جَماهيرِ النَقدْ |
|||
|
وَيلي عَلى شِبلي أما |
|
لَ بِرأسهِ صَوبَ العَمدْ |
|||
لوْ كانَ سَيفُكَ في يَدَ |
|
يْكَ لَما دَنا مِنكَ أحَدْ([41]). |
|
||
وقال سبط ابن الجوزي في (تذكرة الخواص): «ذكر ابن سعد عن أمّ سلمة زوجة النبي أنّها لما بلغها قتل الحسين× قالت: أوَ قد فعلوها؟ ملأ الله قبورَهم ناراً. ثم بكت حتى غُشِي عليها»([42]).
وبعد وصول سبايا الحسين إلى المدينة المنوّرة، خاطبت زينب أخت الحسين المدينة قائلة:
|
مدينةَ جدِّنا لا تقبلينا |
«ثمّ أخذت بعضادتي باب مسجد النبي| وقالت بلهفة: يا جدّاه إنّي ناعية إليك أخي الحسين. ولا زالت بعد ذلك لا تجفّ لها عبرة ولا تفتر من البكاء والنحيب. وكلّما نظرت إلى علي بن الحسين× تجدّدت أحزانها وزاد وَجْدُها»([44]).
وبعد عودة أهل البيت إلى المدينة، توافدت وفود المعزّين في المدينة على آل البيت للمواساة، وكانت العائلة النبويّة تجدّد ذكراها في المدينة صباح مساء في حزن عميق وشجن عظيم وتبكي على الحسين رجالاً ونساءً.
«وكان وجوه المسلمين والموالين لآل البيت يفدون على بيوت آل البيت بالمدينة معزّين ومواسين، وكان الواحد منهم يعبِّر عن مشاعره وأحزانه بأبلغ ما أُوتي من قوّة البيان وحسن المواساة. وبقيت بيوت آل البيت مجلّلة بالحزن والسواد، ولا تُوقَد فيها النيران»([45]).
كان وجود السيّدة زينب أخت الحسين×، في مدينة الرسول ـ بعد عودتها مع السبايا ـ كافياً لأَن يلهب شعور الحُزن والأسى على شهداء كربلاء، وأن يؤلِّب الناس على الطغاة وسفّاكي الدماء، حتى كادَ الأمر من جرّاء ذلك يُفسِد على بني أُميّة، فكتبَ واليهم بالمدينة إلى يزيد: «إنّ وجود زينب بين أهل المدينة مُهيّجٌ للخواطر، وإنّها فصيحة عاقلة لبيبة، وقد عَزَمت هي ومَن معها على القيام للأخذ بثأر الحسين»([46]).
فورَ تسلّم يزيد ـ في الشام ـ هذه الرسالة من عامله والي المدينة، أمَرَه بأن يفرِّق البقيّة الباقيّة من آل البيت في الأقطار والأمصار، فطلبَ الوالي إلى السيّدة زينب بأن تخرج من المدينة، فتُقيم حيث تشاء، فامتَنَعت في بادئ الأمر عن الخروج من المدينة، لكنّها نَزَلت في النهاية على رأي نساء بني هاشم، فخرَجت من المدينة، ورَحَلت إلى مصر، وقد وَصَلتها في أوّل شعبان (61 هـ)، أي بعد مجزرة كربلاء بأكثر من سبعة أشهر([47]).
استُقبِلت السيدة زينب أخت الحسين من أهالي مصر أعظم استقبال، وساروا بها إلى قرية قرب (بلبيس)، وكان في مقدّمة مُستقبليها مَسلمة بن مخلّد الأنصاريّ أمير مصر، فلمّا أطلّت على المستقبِلين أجهشَ الجميع بالبكاء وحفّوا بركبِها، حتّى إذا بلَغت عاصمة مصر مضى بها (مَسلّمة) إلى داره فأقامَت بها قرابة عام.
«وكانت السيدة زينب هي التي جعلت من مصرع الحسين مأساة خالدة لا تعرف ما هو أبعد أثراً في تطوّر العقيدة عند الشيعة، وصيَّرت من يوم مقتله مأتماً سنويّاً للاحزان والآلآم»([48]).
تقول الدكتورة بنت الشاطئ: «وما أحسب أنّ التاريخ قد عرف حزناً كهذا طال أمده حتى استمرّ بضعة عشر قرناً دون أن يفتر، فمراثي شهداء كربلاء هي الأناشيد التي يترنّم بها الشيعة في عيد حزنهم يوم عاشوراء في كلّ عام، ويتحدّون الزمن أن يغيّبها في متاهة النسيان». وتضيف: «وكذلك كانت زينب عقيلة بني هاشم في تاريخ الإسلام وتاريخ الإنسانيّة بطلة استطاعت أن تثأر لأخيها الشهيد، وأن تسلّط معاول الهدم على دولة بني أميّة وأن تغيّر مجرى التاريخ» ([49]).
أخَذَت المآتم والمناحات تُقام في مختلف المدن، والقرى، والقصبات، والدساكر المصريّة سرّاً وجهراً على شهداء الطفّ بكربلاء، على الرغم ممّا كانت تُلاقي من معارَضة ومُناهضة القائمين بالسلطة والحُكم من الأمويّين. وقد اتّسعَ نطاق إقامة هذه المآتم والأحزان والنياحة على الإمام الحسين× في مجزرة كربلاء، في جميع أكناف وأرجاء القطر المصريّ تدريجاً، وخاصّة على زمن الفاطميّين، الذين أطلقوا الحريّة للمصريّين بمزاولة شعائر العزَاء والحُزن على سيّد الشهداء× طوال السَنة، وبالأخصّ في العشرة الأولى من شهر محرّم من كلّ سنة، وخاصّة يوم عاشوراء منه...([50]).
ماتت السيدة زينب عشيّة يوم الأحد، لأربع عشرة مضين من رجب 62هـ، وأُغمضت العينان اللتان شهدتا مذبحة كربلاء وآن للجسد المتعَب المضنى أن يستريح. وبقي قبرها مزاراً مباركاً يَفِد إليه المسلمون حتّى يومنا هذا من كلّ فج عميق([51]).
ومن مشاهد العزاء الحسيني التاريخية التي اعقبت استشهاد الإمام الحسين× ما قام به الذين ندموا على عدم نصرة الإمام الحسين× وعزموا على الاخذ بثاره والذين يُعرَفون بالتوّابين بقيادة الصحابي الجليل سليمان بن صرد الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، فهؤلاء الابطال وقبل ان يذهبوا إلى عين الوردة لمحاربة الجيش الأموي الذي قتل الإمام الحسين× وذلك في العقد الأوّل من ربيع الثاني سنة (65هـ)، ذهبوا اولاً إلى قبر الإمام الحسين×، وعندما وصلوا إليه صاحوا صيحة واحدة، وضجّوا بالبكاء والعويل، فلم يُرَ يومٌ أكثر بكاءً حول قبر الحسين من ذلك، وأقاموا عنده يوماً وليلة يبكون ويتضرّعون، قائلين: «اللهمّ ارحم حسيناً الشهيد ابن الشهيد، اللهمّ إنّا نشهدك أنّا على دينهم وسبيلهم وأعداء قاتليهم وأولياء محبّيهم، اللهمّ إنّا خَذلنا ابن بنت نبيّنا فاغفِر لنا ما مضى منّا وتُب علينا، وإن لم تغفر لنا وترحَمنا لنكوننّ من الخاسرين»([52])، وازدَحموا على لثم القبر كازدحام الحجّاج على لثم الحجر الأسود في الكعبة، ثُمّ ودّعوا القبر ورَحلوا عنه، وبقيَ سليمان بن صرد مع ثلاثين نفراً من أصحابه عند القبر. ثُمّ قامَ من بينهم وهب بن زمعة الجعفي وهو يبكي عند القبر الشريف، وأنشدَ أبياتاً من قصيدة عبيد الله بن الحرّ الجعفي:
|
تبيتُ النشاوى من أُميّةَ نُوّماً |
ثُمّ ساروا عن كربلاء بعد أن باتوا ليلتهم([53]).
رابعاً: النبي واله صلوات الله عليهم يقيمون العزاء على الإمام الحسين×
اول من اقام العزاء على الإمام الحسين× هو جدّه رسول الله| عندما جيء له بالإمام الحسين× وهو ملفوف بخرقة حين ولادته، فاخذه ووضعه في حجره فرحا مسروراً به، فنزل عليه جبرئيل فقال له أوَ تحبه؟ فقال نعم، فقال إنَّ أمَّتَك ستقتله! فبكى رسول الله| لذلك بكاءاً شديداً، وبكى معه جبرائيل وجميع الملائكة والانبياء والمرسلين، والسموات والأرضون، فكان هذا أوَّل بكاء، وأوَّل عزاء أقامه رسول الله| وجبرائيل×، فكان ذلك تأسيسا وتشريعا للعزاء على الإمام الحسين× بدأً من يوم ولادته×، وتكرَّر ذلك البكاء والعزاء من النبي الأعظم|، ومن بعده من الإمام أمير المؤمنين، وأمّه الصديقة الطاهرة وأخيه الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليهم أجمعين، كلُّ ذلك كان قبل شهادته صلوات الله عليه.
وبعد استشهاده× أقام عليه الأئمة المعصومون من ولده^ النوح والبكاء ومجالس العزاء في سرّهم وعلنهم، وفي محافلهم الرسميّة ومجالسهم الخاصّة، وفي دورهم وأنديتهم ودواوينهم، حيث إنّها لم تنقطع، بل استمرّت استمرّار حياتهم([54]). وقد عدّوا مصيبته أعظم المصائب، وأمروا شيعتهم ومواليهم وأتباعهم بذلك، وحثّوا عليه، واستنشدوا الشعر في رثائه، وبكوا عند سماعه، وجعلوا يوم قتله يوم حزن وبكاء، وذمّوا من اتخذه عيداً، وأمروا بترك السعي فيه إلى الحوائج، وعدم ادّخار شيء فيه.
لقد عاش الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين× مدّة أربعين عاماً بعد استشهاد والده في عصر الأمويّين، وكان قد شهد مصرع أبيه وإخوته وبني عمّه وأصحاب أبيه وغيرهم، وتجرّعَ الغصص والغمّ والألم من هذه المشاهد المفجعة، ثمّ قاسى مرارة الأسر ولم تنقطع عبرته على ذلك ما دام حيّاً.
وتنقل الروايات «أنّ عليّ بن الحسين× كان كلّما جاء وقت الطعام وفُتِحت مصاريع الأبواب للناس، ووُضِع طعامه بين يديه دمعت عيناه، فقال له أحد مواليه ذات مرّة: يا ابن رسول الله، أما آن لحزنك أن ينقضي؟» فقال له زين العابدين: «ويحك إنّ يعقوب× كان له اثنا عشر ابناً فغيَّب الله واحداً فابيضّت عيناه من الحزن، وكان ابنه يوسف حيّا في الدنيا، وأنا نظرت إلى أبي وأخي وعمّي وسبعة عشر من أهل بيتي، وقوماً من أنصار أبي مصَرَّعين حولي، فكيف ينقضي حزني؟»([55]).
وروي أنّ الإمام علي بن الحسين× بكى حتّى خِيف على عينيه. وكان إذا أخذ إناءً يشرب ماءً، بكى حتّى يملأه دمعاً. فقيل له في ذلك، فقال: «كيف لا أبكي وقد مُنع أبي من الماء الذي كان مطلقاً للسباع والوحوش». وقيل له: «إنّك لتبكي دهرك، فلو قتلت نفسك لما زدت على هذا». فقال: «نفسي قتلتها وعليها أبكي».
ونقل ابن قولويه عن أبي عبد الله جعفر الصادق× أنّه قال: «ما اختضبت منّا امرأة، ولا دهنت، ولا اكتحلت، ولا رجلت حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد. وما زلنا في عبرة بعده. وكان جدي علي بن الحسين إذا ذكره بكى حتّى تملأ عيناه لحيته، وحتى يبكي لبكائه رحمة له مَن رآه، وإنّ الملائكة الذين عند قبره ليبكون فيبكي لبكائهم كلّ من في الهواء والسماء من الملائكة» ([56]).
وللإمام علي بن الحسين× هذه الأبيات يشير فيها إلى حزن أهل البيت على الحسين بن عليّ:
|
نحن بنو المصطفى ذوو غُصص |
|
يجرعها في الأنام كاظمُنا |
|
عظيمة في الأنام محنتُنا |
|
أوّلنا مبتلى وآخرُنا |
|
يفرح هذا الورى بعيدهم |
|
ونحن أعيادُنا مآتمنا |
|
والناس في الأمن وال، سرور وما |
|
يأمن طول الزمان حائفُنا |
وما خصصنا به من الشـرف الئا يحكم فينا والحكم فيه لنا |
|
ئل بين الأنام آفتنا جاحدنا حقنا وغاصبنا([57]) |
وقال الإمام محمّد الباقر×: كان عليّ بن الحسين يقول: «أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي× دمعةً حتى تسيل على خدّه لِأذىً مسّنا من عدوّنا في الدنيا، بوّأه اللهُ مبوّأ صدقٍ في الجنّة»([58]).
أمّا الإمام الخامس محمّد بن عليّ بن الحسين الباقر× فقد شحّت الروايات عن ذكر إقامة المآتم والنياحات العلنيّة في عهده. وسبب ذلك هو شدّة ضغط الأمويّين عليه وعلى آله وصحبه، الأمر الذي كان يدعو الإمام والناسَ إلى اتخاذ جانب الحيطة والحذر والتقيّة، وإقامة مثل هذه المآتم في بيوتهم الخاصّة وراء الأستار الكثيفة، ولم يحضرها سوى خاصّتهم.
قدِم الكميت بن زيد المدينة وأنشد الإمام محمّد الباقر بن علي بن الحسين، فلما بلغ من الميمية قوله:
وقتيل بالطفّ غُودِر منهم بين غوغاء أمةٍ وطغام |
بكى الإمام الباقر، ثمّ قال: يا كميت، لو كان عندنا مالٌ لأعطيناك، ولكن لك ما قال الرسول لحسان بن ثابت: «لا زلت مؤيّداً بروح القدس ما ذببتَ عنّا أهل البيت..»([60]).
أمّا الإمام السادس جعفر بن محمّد الصادق×، فإنّه كان من أكثر الأئمّة حزنا وبكاءً ونياحة على جدّه الإمام الحسين. والروايات في وصف بكائه ونحيبه كثيرة ومتواترة.
روى ابن قولويه في الكامل بسنده عن أبي بصير قال: «كنت عند أبي عبد الله الصادق فدخل عليه ابنه فقال له: مرحباً وضمّه وقبّله، وقال: حقّر الله من حقّركم، وانتقم ممّن وتركم، وخذل الله من خذلكم، ولعن الله من قتلكم، وكان الله لكم وليّاً وحافظاً وناصراً، فقد طال بكاء السماء وبكاء الأنبياء والصدّيقين والشهداء، وملائكة السماء، ثمّ بكى وقال: يا أبا بصير، إذا نظرت إلى ولد الحسين أتاني ما لا أملكه بما أوتي إلى أبيهم وإليهم. يا أبا بصير إنّ فاطمة لتبكي...»([61]).
وقال الإمام الصادق×: «وما من عين أحبّ إلى الله ولا عبرة من عين بكت ودمعت عليه، وما من باكٍ يبكيه إلّا وقد وصل فاطمة وأسعدها عليه، ووصل رسول الله| وأدّى حقّنا. وما من عبد يحشر الّا وعيناه باكية الّا الباكي على جديّ، فإنّه يُحشر وعينُه قريرة، والبشارة تلقاه، والسرور بيِّن على وجههِ»([62]).
رُوي عن الإمام الصادق× أنّه قال: «من قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى غفر الله له، ووجبت له الجنة»([63]).
نُقل عن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا× المدفون في مشهد بخراسان أنَّه قال: «كان أبي (موسي الكاظم) إذا دخل محرّم لا يُرى ضاحكاً، وكانت الكابة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام. فاذا كان اليوم العاشر منه كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه. ويقول هو اليوم الذي قُتل فيه جدي الحسين»([64]).
روى الصدّوق في الأمالي بسنده عن الإمام علي بن موسى الرضا× قال: «إنّ المحرَّم شهر كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه القتال، فاستُحلِّت فيه دماؤنا، وهُتِكت فيه حرماتنا، وسُبيَ فيه ذرارينا ونساؤنا، وانتُهبت ما فيها من ثقلنا، ولم تَرعَ لرسول الله| حرمة في أمرنا. إنّ يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذلَّ عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الإنقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكِ الباكون، فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام»([65]).
وروى الصدوق في الأمالي بسنده عن الريَّان بن شبيب قال: «دخلتُ على الرضا في أوّل يوم من محرّم. قال: يا ابن شبيب، إنّ المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة في ما مضى يحرّمون فيه الظلم والقتل لحرمته، فما عرفت هذه الأمّة حرمة شهرها، ولا حرمة نبيّها|، لقد قتلوا في هذا الشهر ذريّته وسبَوا نساءه، وانتهبوا ثقله، فلا غفر الله لهم ذلك أبداً. يا ابن شبيب، إن كنتَ باكياً لشيء فابكِ للحسين بن علي بن أبي طالب، فإنّه ذُبح كما يُذبَح الكبش، وقُتِل معه أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيه، ولقد بكت السماوات السبع والأرضون السبع لقتله، ولقد نزل إلى الأرض من الملائكة أربعة الآف لنصره فوجدوه قد قُتِل. فهم عند قبره شعث غبر إلى أن يقوم القائم (الإمام المهدي المنتظر) فيكونون من أنصاره وشعارهم (يا لثارات الحسين). يا ابن شبيب، لقد حدّثني أبي، عن أبيه عن جدّه أنّه لما قُتل جدي الحسين، أمطرت السماء دماً وتراباً أحمرَ. يا ابن شبيب، إن بكيتَ على الحسين حتى تصير دموعك على خديك، غفر الله لك كلّ ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً...»([66]).
وحُكيَ عن الشاعر دعبل الخزاعي أنّه قال: «دخلتُ على سيدي ومولاي عليّ بن موسى بمَرْو في أيام عشرة المحرم، فرأيته جالساً جلسة الحزين الكئيب، وأصحابه جلوس حوله. فلما رآني مقبلا قال لي: مرحباً بك يا دعبل، مرحباً بناصرنا بيده ولسانه، ثمّ إنّه وسّع لي في مجلسه، وأجلسني إلى جانبه، ثمّ قال: يا دعبل أُحبُّ أن تنشدني شعراً فإنّ هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بني أميّة. ثمّ إنّه نهض وضرب ستراً بيننا وبين حَرَمِه وأجلس أهل بيته من وراء الستر، ليبكوا على مصاب جدّهم الحسين. ثمّ التفت إليّ وقال: يا دعبل، اِرثِ الحسينَ، فأنت ناصرنا ومادحنا ما دمت حيّاً. قال دعبل: فاستعبرت وسالت دموعي وأنشأت:
|
أفاطمُ لو خِلتِ الحسينَ مُجدَّلا |
إلى آخر القصيدة التائيّة التي تناقلتها كتب التاريخ وأسفار الحديث، وعدّتها من أبلغ القصائد رثاءً وفجيعةً وحزناً»([67]).
وروى الصدوق في (عيون أخبار الرضا) بسنده عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: «دخل دعبل بن عليّ الخزاعيّ على أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا بمرو فقال له: يا ابن رسول الله، إنّي قد قلت فيكم قصيدة، وآليت على نفسي أن لا أنشدها أحداً قبلك. فقال: هاتها فأنشده:
|
مدارسُ آياتٍ خلتْ منْ تلاوةٍ |
فلما بلغ البيت:
|
أرَى فيئِهِم في غيْرِهِم مُتقسّما |
بكى الإمام الرضا، وبكت معه النسوة والأطفال. ولا زال الشيعة يتلونها إلى اليوم على المنابر ويبكون»([68]).
وقصيدة دعبل الخزاعي بلغت 120 بيتاً، وكلّ أبياتها شجيّة ومن أشجاها البيتان:
|
سأبكيهم ما ذرَّ في الأرض شارقٌ |
ونقلت كتب الحديث عن الإمام عليّ بن موسى الرضا× عن يوم عاشوراء ما يلي: «من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله} يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرّت في الجنان عينه ومن سمّى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيه لمنزله شيئا لم يبارك فيما ادّخر»([70]).
خامساً: أول من بدأ اقامة العزاء الحسيني الإيرانيّون أم العراقيّون؟
السؤال الذي يُطرح هنا هو مَن بدأ مراسم العزاء الحسيني أولاً الإيرانيّون أو العراقيّون؟ وهل العرب نقلوا مراسم العزاء إلى إيران أم العكس هو الصحيح؟
يبدو أنّ المؤرخين يتفقون على أنّ العراقيّين هم الذين بدأوا العزاء على الحسين؛ لأنّ الحسين استُشهد في أرض كربلاء، وأنَّ من زاروا قبره هم ممّن كانوا يعيشون بالقرب من المدينة، أو الذين قصدوا قبره من مناطق بعيدة، والروايات التاريخيّة تؤكّد ذلك. ويرى الباحث العراقيّ إبراهيم الحيدري بأنَّ الاحتفالات بيوم عاشوراء في العراق، هي أقدم بكثير ممّا هي في إيران، وإنّها بدأت منذ القرن الثالث للهجرة وعلى شكل زيارات منتظمة لقبر الحسين في كربلاء، وإلقاء المراثي حول مقتله، وكذلك التجمّع في بيوت الأئمّة من أهل البيت وإقامة (النياحة) عليه، إضافة إلى الاحتفالات بيوم عاشوراء التي أقيمت في بغداد زمن البويهيّين، وإقامة مواكب الندب والبكاء التي طافت شوارع بغداد مصحوبة بالموسيقى والأعلام([71]).
ويمكن أيضاً أن تكون هذه الشعائر والطقوس قد انتقلت من العراق إلى إيران وغيرها من الدول العربيّة والإسلاميّة من طريق العلماء والخطباء والدعاة من جهة، ومن طريق الزوّار الذين جاءوا إلى العراق لزيارة العتبات المقدّسة من جهة أخرى، خصوصاً إذا علمنا أنّ الصفويّين شجّعوا ممارسة الشعائر والطقوس الدينيّة ومراسم العزاء الحسينيّ، وزيارة العتبات المقدّسة في العراق لنشر التشيّع([72]). فضلاً عن أنّ الملوك الصفويّين، قد استدعوا العلماء من النجف وجبل عامل إلى إيران لتعليم الناس أصول المذهب([73]).
يعتقد الكاتب الإيرانيّ عبد الله المستوفي «أنّ إقامة المواكب الحسينيّة والخروج من الحسينيّات والتكايا على شكل مواكب العزاء والسير في الشوارع واللطم على الحسين وقراءة المراثي والنواح على الحسين جاء من العرب إلى إيران»([74]). ولكن الإيرانيّين نقلوا طقوس العزاء إلى بلدان عربيّة منها لبنان وبلدان آسيويّة منها الهند.
والملاحظ عند مقارنة العزاء الحسيني في العراق وإيران أنّ العراقيّين عندما كانوا يقيمون مراسم العزاء على الحسين بن علي، كانوا ينطلقون من الشعور بالظلم؛ نتيجة ما وقع عليهم من مصائب منذ حكم الأمويّين، وما عانَوه من تمييز بينهم وبين المذاهب الأخرى في العراق، ومن حرمان من حقوقهم كمواطنين؛ ولذلك كانوا يصبغون مراسم العزاء بالشعارات السياسيّة، معلنين تحدّيهم للسلطات الحاكمة التي كانت تفرض عليهم مزيداً من الضغوط والتفرقة بينهم وبين مواطنيهم العراقيّين من المذاهب الأخرى، وكان العراقيّون يتّخذون من مراسم العزاء على الإمام الحسين فرصة للإعراب عن معارضتهم للسلطات، وتحدّيهم للأنظمة الحاكمة. وكان الشعراء ينظمون القصائد السياسيّة ضدّ الحكومة كما كان الشعراء الشعبيّون ينظمون القصائد باللهجة العاميّة؛ ليردّدها المعزّون خلال مشاركتهم في المواكب الحسينيّة في شهر محرّم.
بينما لم نجد السلوك نفسه عند الإيرانيّين خلال الاحتفال بمراسم عاشوراء، إذ إنّ المراسم التي كانت تُقام في المدن الإيرانيّة كانت تعبّر عن الحزن والأسى لما لاقاه الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته من ظلم وجور من حكّام بني أميّة، ولم ترافقها شعارات سياسيّة؛ لأنَّ حكّام إيران في العصرين البويهيّ والصفويّ كانوا شيعة، وكانوا يشجّعون الشيعة على إقامة مجالس العزاء، أو إقامة عروض التعزية في التكايا والحسينيّات. ولم يخلُ تاريخ إيران من حكّام اضطهدوا الشيعة ومنعوهم من إقامة العزاء على الإمام الحسين. فقد اتخذ العديد من الحكّام الذين حكموا إيران في القرون الأولى من الهجرة مواقف معادية من الشيعة، ولم يسمحوا لهم بإقامة مراسم العزاء، وكان الشيعة يقيمون العزاء خفية في البيوت، ولكن عندما كانوا يواجهون حكّاماً أقلّ تشدّداً، كانوا يقيمون مراسم وطقوس الحزن والعزاء على الإمام الحسين× علناً.
سادساً: الخطباء والشعراء واصحاب المقاتل و... ودورهم في احياء العزاء الحسيني
منذ أن نشأت التعزية عند الشيعة بعد استشهاد الإمام الحسين× في كربلاء، كانت هناك عوامل عديدة أثّرت في تعزيز مجالس العزاء واستمرارها ووصولها إلينا في الوقت الحاضر. ومن العوامل التي ساعدت على استمرار مجالس العزاء وجود عناصر بشريّة وإنسانيّة أعطت العزاء زخماً وقوّة. ومن هؤلاء: الخطباء، والوعّاظ، والرواديد، والنائحون والمنشدون، والشعراء، والشعراء الشعبيّون، والقصّاصون، والرواة، والممثّلون، والرسّامون، والكتّاب وغيرهم، واليك موجزاً عنهم:
إنّ أهمّ عامل في إقامة العزاء واستمراره وديموميته هو وجود خطيب، أو واعظ يخطب في المعزّين، ويشرح لهم واقعة كربلاء، وما لاقاه الحسين وأصحابه وأنصاره من ظلم وعدوان، انتهى باستشهادهم في كربلاء. لقد كان للخطباء دور كبير في توعية الناس في وقت لم تكن وسائل الإعلام متوافرة آنذاك. فالخطباء كانوا ينقلون أحداث عاشوراء في مجالسهم، وكانوا يُطلِعون المشاركين في المجالس على المعلومات التي تتحدّث عمّا لحق بالحسين وأصحابه من ظلم وجور وتعسّف وقمع.
وبرز خلال قرون مضت عدد كبير من الخطباء في إيران والبلدان العربيّة، اختصّوا بذكر فاجعة كربلاء ومقتل الحسين وعرفوا بخطباء المنبر الحسينيّ، وكان لهم الأثر الكبير في إحياء ثورة الحسين×. وشهد المنبر الحسينيّ خطباء كبار خلال مئات السنين، حيث كانوا يعتلون المنابر، ويتحدّثون عن فاجعة كربلاء وكان لهم الدور الكبير في توعية الشيعة وتثقيفهم أمام ما يتعرّضون له من ظلم وقمع.
هم من يقومون بوعظ الناس على المنابر وإرشادهم، ومهمّتُهم تشبه مهمّة الخطباء. وهؤلاء يصعدون منابر الخطابة ويقومون بوعظ الناس لا سيّما في شهر محرّم، وبمناسبة استشهاد الحسين. ويتمتّع الواعظ بصوت جَهْوَريّ، وله اطلاع على ألاحداث والوقائع العاشورائيّة.
فالواعظ بعد أن يبدأ خطبته وبعد قراءة آية من القرآن الكريم يقوم بشرح الآية الكريمة ويذكر الأمثال والحكم والأشعار وينهي مجلس العزاء بذكر مصيبة الحسين يوم عاشوراء([75]).
هم من يذكرون الله ويهدفون من وراء ذلك إلى الحصول على الثواب الأخرويّ، ولا فرق بين الفرق الإسلاميّة لأنّ جميع الفرق والمذاهب سواء الشيعة أو السنة أو المتصوّفة، تقيم مجالس الذكر والدعاء في مناسبات خاصّة بها. فالذاكرون الشيعة يردّدون أشعاراً في مدح الرسول محمّد| والإمام علي وأهل البيت^. والذاكرون المتصوّفة يردّدون أشعار الصوفيّة ولا سيّما في البلدان العربيّة في الخانقاه أو الزوايا المخصصّة لإقامة مراسمهم التي تُعرف بالسماع وأغاني الصوفيّة، والذاكرون يقومون بذكر الحوادث والوقائع الدينيّة، ويذكرون المصائب التي حلّت بأهل بيت رسول الله|. وكان هؤلاء يتمتّعون بصوت شجيّ وعلى علم بالموسيقى وكانوا يجذبون عدداً كبيراً من المستمعين. فضلاً عن إطلاعهم الجيّد على معلومات يحتاج اليها الذاكر([76]).
قرّاء المقاتل: كان العديد من الخطباء قد اختصّوا بقراءة قصّة واقعة كربلاء التي أُطلق عليها (مقتل الحسين) وعرفت الكتب التي كُتبت خصِّيصاً لواقعة كربلاء باسم (مقاتل الحسين). وكان قرّاء المقاتل يقرأون المقتل يوم عاشوراء خلال تجمّع عدد كبير من المواطنين.
ظهرت كتب كثيرة باسم مقتل الحسين كتبها أفراد تبحّروا بجمع روايات واقعة كربلاءوعُرفوا بكتّاب المقاتل. ومن أهم كتب المقاتل:
مقتل أبي مخنف: وهو لوط بن يحيى الأزدي الغامديّ (المتوفّى في العام 157هـ)([77])، والكتاب مفقود إلا أنَّ رواياته نقلتها المصادر التاريخية التي جاءت بعده، ومنها تاريخ الطبريّ حيث اعتمد في نقله لمقتل الإمام الحسين× على مقتل أبي مخنف بشكل أساسي.
مقتل الحسين لأصبغ بن نباتة المجاشعي، والمشهور أنّه أقدم المقاتل([78]).
مقتل الحسين للشيخ الصدوق (مفقود).
مقتل الحسين لأبي المؤيَّد الخوارزمي المتوفّى في العام 568هـ (مطبوع).
مقتل الحسين لابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس المعروف بالسيّد بن طاووس المتوفّى في العام 664هـ. ويسمّى هذا المقتل بـ(اللهوف على قتلى الطفوف) أو (الملهوف على قتلى الطفوف) (مطبوع).
مثير الأحزان: لنجم الدين جعفر بن محمّد بن جعفر بن هبة الدين الحلّي المتوفّى في العام 841هـ المعروف بـ(ابن نما) (مطبوع).
روضة الشهداء (بالفارسيّة): من تأليف الملا حسين واعظ كاشفي المتوفّى في العام 910 هـ، (مطبوع).
(نفس المهموم في مصيبة سيّدنا الحسين المظلوم) للشيخ عبّاس القميّ (المحدّث القميّ)، (مطبوع)([79]).
الشعراء: منذ واقعة كربلاء برز شعراء كثر خلّدوا ذكرى عاشوراء بقصائدهم. وشرحوا ما أصاب الحسين وأهل بيته من ظلم وعدوان. وقد لقي هؤلاء الشعراء تشجيعاً من أئمّة أهل البيت؛ لما كان لهم من أثر في نشر واقعة كربلاء.
وظهرت طبقة من الشعراء كانت تمدح الرسول والأئمّة من أهل البيت، مقابل الشعراء الذين كانوا يمدحون الملوك والخلفاء في العصرين الأمويّ والعبّاسيّ. وأطلق العديد من الشعراء الفرس لقبَ الشاه أي الملك على الإمام علي والإمام الحسين، كما أطلقوا في قصائدهم ألقاباً مثل: شاه دين [ملك الدين] ويعادلها في العربيّة سيّد الدين، شاه مردان [سيّد الرجال]، شاه شهيدان [سيّد الشهداء]، شاه جهان [سيّد العالم]، شاه مظلومان [سيّد المظلومين] وشاه شرف [سيّد الشرف]، وشاه خراسان [سيّد خراسان]([80]).
ظهر في العالم العربيّ شعراء شعبيّون خلّدوا ذكرى الحسين، ونظموا أشعاراً بالعربيّة الدارجة، وقد عُرف هؤلاء الشعراء بالشعراء الشعبيّين. وكُتبت أشعارهم باللهجة العاميّة، ومن أشهر الشعراء الشعبيّين في العراق الشاعر كاظم منظور الكربلائيّ الذي خلّف دواوين كثيرة في رثاء الحسين وأهل بيته.
المنشدون أو الرواديد أو النائحون أو قرّاء التعازي والمراثي
ظهرت طبقة من المنشدين أو الرواديد أو النائحين أو قرّاء التعازي والمراثي في إيران والعراق والبلدان العربيّة ذوي أصوات شجيّة، ويقرأون الأشعار العاميّة في رثاء الإمام الحسين وأهل بيته. وهؤلاء المنشدون يقرأون الشعر الشعبيّ بين مجموعة من الناس الذين يلطمون على صدورهم إحياءً لذكرى الحسين بن علي.
القصّاصون والرواة والحكواتيّون
كان القصّاصون والرواة والحكواتيّون ينقلون قصص الحروب والبطولات، ولا سيّما واقعة كربلاء وبطولات الحسين وأهل بيته وأصحابه في مواجهة جيش يزيد بن معاوية. وهؤلاء القصّاصون كانوا يتمتّعون بصوت شجيٍّ وجَهْوَريٍّ وكانوا يتخذون من المقاهي والأماكن العامّة مكاناً لهم يقرأون الأشعار الحماسيّة ويروون القصص لمستمعيهم([81]).
وقد اندثرت مهنة القصّاصين والرواة والحكواتيّين، بعد أن بدأ عمل الإذاعة والتلفزيون، ولم يعد هؤلاء يمارسون مهنتهم حاليّاً.
ظهرت طبقة قرّاء المناقب أو المناقبيّون في القرن الرابع للهجرة، وكان هؤلاء يقرأون أشعاراً في مدح الإمام عليّ وأولاده من أئمّة أهل البيت، ويذكرون معتقدات الشيعة مثل التنزيه والعدل والتوحيد وعصمة الأئمّة ومعجزاتهم. وكانوا يسيرون في الشوارع والأزقّة، كما كانوا يروون القصص الحماسيّة والدينيّة عن بطولات الإمام عليّ والحسين بن عليّ في مواجهة أعدائهم. كان المناقبيّون شيعة موالين للإمام عليّ وكانوا يتعرّضون أحياناً للصحابة، وقد ظهروا في طبرستان وبعض مناطق العراق. وذكر عبد الجليل القزوينيّ الرازيّ صاحب كتاب (النقض): أنّ الفضائليّين (من أهل السنة الذين يروون فضائل الصحابة) كانوا يصفون المناقبيّين الشيعة بأنّهم رافضة ويلعنونهم([82]).
فالمناقبيّون كانوا يسيرون في الشوارع والأسواق والأزقّة في بغداد ويقرأون أشعاراً بصوت عالٍ في مدح أهل البيت والأئمّة وذكر مناقبهم. كما كان المناقبيّون ينشطون في إيران منذ العصر البويهيّ، واستمرّ نشاطهم بصورة سريّة في العصر السلجوقيّ في العراق وطبرستان، وكانوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى من أجل الحيلولة دون تعقّبهم وإلحاق الأذى بهم([83]).
فالحريّات الدينيّة في عهد البويهيّين جعلت الشيعة يوسّعون نشاطاتهم. وكان قرّاء المناقب يشكّلون وسيلة إعلاميّة للشيعة. وكان هذا العمل يجذب محبّي أهل البيت نحو الشيعة. وكان الشيعة يبلغون معتقداتهم ومذهبهم من هذا الطريق([84]). والجدير بالذكر أنّ خطباء المجالس حلّوا تدريجيّاً محلّ قرَّاء المناقب في القرن العاشر للهجرة.
ونقل المؤرّخون بأنّ قرَّاء المناقب كانوا ينشطون في محلّة الكرخ ببغداد في العهد البويهيّ، وكانوا يتعرّضون للضرب من أهل السنّة. وكان أبو طالب المناقبيّ من المناقبيّين المعروفين في بغداد في العهد السلجوقيّ، إذ أصدرت سلقم بنت ملكشاه (السلجوقيّ) (زوجة اسبهبد علي درساري) أمراً بقطع لسانه، ولكن هذا العمل لم يثن المناقبي عن مواصلة عمله، وكان حتى آخر حياته يقرأ المناقب في مختلف المدن الإيرانيّة، ولا سيما في الريّ وقزوين وقم وكاشان وآبه ونيسابور وسبزوار وجرجان ومازندران([85]).
وهَرَب مناقبيٌ آخر يُدعَى أبو الحميد المناقبي من الرَّيّ إلى مدينة ساري، وحظي باحترام الشيعة هناك. وكانت مجموعة من الشيعة تلبس ملابس رثّة، وتقوم بأعمال المجانين، وتمشي في الأزقّة والأسواق، وتقرأ مناقب أهل البيت وتذكر مثالب خصومهم، ولم يتعرَّض السنّة لهم ؛لأنّهم كانوا يبدون كالمجانين([86]).
ولم يكتفِ خصوم الشيعة في مواجهة ظاهرة المناقبيين على الترهيب والتنكيل بل أوجدوا ضدّاً نوعياّ لتلك الظاهرة، تُمثَّل بإنشاء مجاميع سُمِّيت بعد ذلك بالفضائليين([87])، يطوفون في الأزقّة والأسواق، يظهرون مدح الصحابة والأولياء ولا سيّما الخلفاء الثلاثة، وكانوا في نفس الوقت يظهرون الطعن بالشيعة، وكان الواحد من هؤلاء يُسمّى بالفضائلي أو قارئ الفضائل([88]).
وفيه مبحثان:
المبحث الاول: العزاء الحسيني في العراق
المبحث الثاني: العزاء الحسيني في البلدان العربية الاخرى
المبحث الأوَّل
موقف السلطات الأموية والعباسية من العزاء الحسيني
لا يخفى أنَّ شهادة الإمام الحسين كانت ثورة ضدَّ الظالمين والطواغيت، وأنَّ إقامة العزاء عليها يمثِّل إحياءاً لها، وهذا بطبيعة الحال لا يروق للسلاطين الظلمة في كلِّ زمان؛ ولهذا سعَوا إلى إماتتها والمنع من إحيائها، أو التذكير بها، وكان من أبرز تلك الممارسات التي سعت إلى منعها هو إقامة مجالس العزاء والبكاء على الإمام الحسين، أو زيارة قبره؛ لأنَّ ذلك من أبرز مصاديق التذكير بتلك النهضة المرفوضة عند السلاطين؛ لهذا سعوا إلى منعها بكلِّ السبل، وعاقبوا من يقوم بها بأنواع العقوبات، هذا ما سجَّله لنا التاريخ عن موقف الدولة الأموية والعباسية ولكن بالرغم من هذا الإصرار على المنع إلا أنَّ العزاء الحسيني وبهمَّة الموالين وبتوجيهات أئمة اهل البيت^ كان يتحرَّك ولكن في أغلب الأحيان كان سرا خوفاً من السلطان. نعم في بعض الظروف السياسية الخاصَّة تبرز بعض المظاهر العلنية المحدودة، واستمرَّ الوضع هكذا حتى مجيء الدولة البويهية حيث تغيَّر الوضع السياسي لصالح الشيعة، واستطاعوا أن يقيموا العزاء الحسيني علناً، ومن هنا كان العزاء الحسيني في العراق وغيره من البلدان الإسلامية مرتبطاً بموقف السلطات الحاكمة، وعليه ووفقا لهذه المعادلة السياسية نستطيع أن نحدِّد حركة العزاء الحسيني في العراق، وكيف كان، وكيف تطور.
ومن الفترات التي سبقت قيام الدولة البويهية وتعتبر فترة استراحة للشيعة واتباع اهل البيت^ هي الفترة الاخيرة من الحكم الاموي والفترة الاولى من الحكم العباسي حيث انشغلت الدولتان ببعضهما البعض وتصفية خصومهما فوفر انشغاله ذلك فرصة للإمام محمّد الباقر وابنه الإمام جعفر الصادق÷ لبثّ علوم أهل البيت، ونشرها على الناس، وإحياء ذكرى الإمام الحسين وإذاعتها والنياحة عليه علناً بعد أن كانت سرّاً([89]).
وقد استفاد الشيعة من هذه المدّة القصيرة لزيارة قبر الإمام الحسين بكربلاء وإقامة المناحات حوله، وإظهار حزنهم في العشرة الأولى من محرّم، وخاصّة يوم عاشوراء، وإعادة الذكريات الأليمة لهذا اليوم، ولكنها كانت قصيرة؛ حيث لحقتها حقبة الحكم العبّاسيّ الذي كانت محاربته للنهضة الحسينيّة أعظم بكثير من مقاومة الحكم الأمويّ([90]).
وكان في مقدّمة الخلفاء العبّاسيّين أبو جعفر المنصور الذي كان أوّل من أمر بهدم قبر الحسين ومنع الزوار من زيارته وإقامة المآتم والمناحات حوله وفي الجهات الأخرى، بخلاف سلفه أبي العبّاس السفاح الذي ساير الشيعة كثيرا؛ ليستعين بهم ضدّ بقايا الأمويّين؛ إذ سمح لهم بإقامة شعائرهم ومآتمهم وبزيارة قبر الحسين وإقامة العزاء عند قبره، وفي دُورِهم ومجتمعاتهم ومحافلهم([91]).
عاصر الإمام الصادق× الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة، وتحمّل منهما ما تحمّل، ولكن أشدّ حقبة مرَّت عليه كانت حكم المنصور، فقد حبس بعض أصحابه، ومنهم عبد الحميد وسدير وعبد السلام، وقتل آخرين، منهم المعلَّى بن خُنيس، فضلاً عن فتكه بالطالبيّين مثل عبد الله بن الحسن وولديه: محمّد وإبراهيم وجمهور كبير من آل الحسن([92]). توفّي الإمام جعفر الصادق في الخامس والعشرين من شهر شوال سنة 148 للهجرة، متأثّراً بسمّ دسّه إليه المنصور العبّاسيّ على يد عامله على المدينة محمّد بن سليمان([93]).
وقد تعرّض الإمام موسى الكاظم× والشيعة في زمانه لمضايقات من الخلفاء العبّاسيّين، ولا سيّما هارون الرشيد، وقُیِّدت حركاته وسكناته. وكانت الضغوط على أهل البيت كبيرة ورهيبة للغاية، فأصبحت اجتماعاتهم ومجالسهم محدودة جدّاً، ومراقبة مراقبةً شديدة كما كانت تُحصى حركاتهم وسكناتهم وحتّى أنفاسهم، خاصّة وأنّ الإمام موسى بن جعفر عاش مدّة من عمره في ظلمات السجون، فقد سجنه المهدي العبّاسيّ ثمّ أطلقه، وسجنه هارون الرشيد في البصرة عند عيسى بن جعفر، ثمّ نقله إلى بغداد عند الفضل بن الربيع، ثمّ عند الفضل بن يحيى، ثمّ عند السندي ابن شاهك. فالمدّة التي قضاها الإمام موسى بن جعفر في سجون هارون الرشيد بلغت أربع سنوات، وفي بعض الروايات أكثر من ذلك([94]).
فهارون الرشيد أمر بهدم قبر الإمام الحسين وكرب موضعه، وقصَّ شجرة السدرة التي كانت بجوار القبر سنة 171هـ، ومنع إقامة المآتم والمناحات، سواء على القبر، أو في دور الشيعة ومجتمعاتهم ومجالس العزاء([95]). بعد وفاة هارون الرشيد في خراسان سنة 193هـ، أصبح ابنه الأمين يتساهل مع الشيعة وجدّد بناء سقيفة قبر الحسين وسمح للشيعة بإقامة المآتم والمناحات على قبر الحسين.
عندما تولّى المأمون الحكم أخذ يساير الشيعة وخفّف من وطأة الضغط عليهم وسمح تدريجيّاً للوافدين على كربلاء بزيارة قبر الحسين وإقامة المآتم حوله، كما فسح المجال للشيعة في مختلف البلدان الإسلاميّة بإقامة العزاء والمناحات على الحسين في أيام السنة وخاصة في العشرة الأولى من محرّم كلّ عام([96]).
وفي عهد الإمام التاسع محمّد الجواد التقي×، نال الشيعة بعض الحريّة في إقامة شعائرهم هذه، لأنّ الخليفة المأمون كان متساهلاً معهم، لا سيّما وأنّ الإمام محمّد الجواد كان صهره على ابنته أمّ الفضل، وكانت المآتم على الإمام الحسين× تقام في دور العلويّين علناً ومن دون أيِّ ضغط، وليس من يعارضهم في ذلك، ولكنَّ الإمام محمّد الجواد× لم يسلم من يد العبّاسيّين؛ فقد قيل إنّه توفّي بسمّ أمر المأمون بدسّه له([97]).
وكان المعتصم يسعى لمراعاة شعور العلويّين والموالين لآل البيت، في دورهم وخارجها، سراً وعلناً.
ولكنّ جعفر المتوكّل كان أكثر العبّاسيّين استهتاراً ومطاردة للشيعة، وقد سار على طريقة جدّه هارون الرشيد، فطارد الشيعة وضيّق الخناق عليهم، ومنع إقامة أيّ مناحة أو مأتم على الحسين، وهدم قبره عدّة مرات ثم كربه وحرثه وأسال الماء عليه، وأقام المراصد والمسالح على السبل المنتهية إلى قبر الحسين، وحجز زائريه عن زيارته، وعاقبهم بالقتل والتمثيل، على يد قائده اليهودي ديزج.
ولكنّ ابنه المنتصر عارض أباه في كلّ ذلك، بل أعاد قبر الإمام الحسين إلى ما كان عليه، وأصلح القبور حوله، وأطلق الحرية للشيعة في زيارة مثوى الإمام، وإقامة المآتم والمناحات حوله وفي دورهم ومحلّات عبادتهم. كما أمر بإقامة علامات يستدلُّ به الزائر على قبر الإمام الحسين. وقد تزايد وفود الزوار ولا سيّما العلويّون على زيارة قبر الحسين وإقامة المآتم والعزاء حوله، ثمّ السُّكنى إلى جواره.
وكان في مقدِّمة هؤلاء المجاورين السيد إبراهيم المجاب، الضرير الكوفيّ، الجدّ الأعلى لكثير من الأسر العلويّة. وقد وضع السيد إبراهيم الحجر الأساس لمجالس العزاء والمآتم والمناحات الدائمة على الإمام الحسين حول قبره بصورة منتظمة، ونزل المجاب كربلاء في العام 247هـ([98]).
وعلى عهد الأئمّة الثلاثة الآخِرين ـ وهم الإمام علي الهادي والحسن العسكري والمهدي المنتظر^ ـ أخذت السلطات الحاكمة بإيعاز من الخلفاء العبّاسيّين الذين خلفوا المعتصم ومنهم المتوكّل تشدِّد على هؤلاء الأئمّة وشيعتهم ومواليهم، وتمنعهم من إقامة شعائر العزاء والحزن على الحسين، وتحدّ من حرياتهم في ذلك، وتمنعهم من إقامة شعائر العزاء والحزن على الحسين، غير أنّ المقيمين لهذه المأتم لم يمتنعوا عن إقامتها سرّا في دورهم، وإن لم يستطيعوا إقامتها علناً وجهاراً، وكانوا يستعملون التقيّة، ويسدلون الأستار على الأماكن التي كانوا يقيمون فيها هذه الشعائر الحزينة في دورهم، وخاصّة عند قبور الأئمّة، كقبر الإمام الحسين بكربلاء، وقبر الإمام عليّ في النجف، وقبري الإمامين الجوادين في الكاظميّة ومقابر قريش؛ ولذلك نجد أنّ أخبار وروايات إقامة هذه الشعائر على عهد هؤلاء الأئمّة الثلاثة شحيحة جدّاً([99]).
وهكذا كان شأن إقامة هذه النياحات والمآتم، وحفلات الحزن وشعائر العزاء على الحسين الشهيد، على عهد الأئمّة الإثني عشر بين مدٍّ وجَزْر، ولكنّهم كانوا لا يتركون أيّ فرصة في كلِّ عصر وجيل إلّا حثّوا شيعتهم ومواليهم على البكاء على الحسين، والحزن لقتله، ورثائه بالأشعار والقصائد، وإقامة العزاء والمآتم عليه، وعُدّ يوم عاشوراء يوم حزن وبكاء ونياحة([100]).
البويهيّون أوّل من أمر بإقامة طقوس العزاء علناً
يرتبط إقامة العزاء الحسيني في العراق ارتباطا وثيقا بالدولة البويهية التي تولَّت الحكم في العراق وبقية البلدان الإسلامية من العام 334هـ إلى العام 467هـ، أي 133 عاماً، ففي هذه الفترة الزمنية تحرَّرت الشيعة من المنع الذي فرضته الدولة الأموية والعباسية على إقامة العزاء الحسيني بعد أن أصبحت السلطة بيد الشيعة ومن الطبيعي أن يتحرَّر العزاء الحسيني ويصبح علنيا، وهذا ما فعلته الدولة الاموية حيث أعلنت وبشكل رسمي ولأوَّل مرة بعد استشهاد الإمام الحسين× أن يُقام العزاء الحسيني بشكل علني، ومنذ ذلك الوقت أخذ العزاء الحسيني بالانتشار والتطوُّر والتكامل.
يقول ابن الأثير: «في هذه السنة، (352هـ/963م) في العاشر من محرّم، أصدر معزّ الدولة (أحمد البويهيّ)([101]) أمراً بأن يغلقوا (الناس) دكاكينهم، ويعطّلوا الأسواق والبيع والشراء، وأنْ يُظهروا النياحة، ويلبسوا قباباً عملوها بالمسوح، وأن يخرج النساء منشورات الشعور، مسوَّدات الوجوه، قد شققنَ ثيابهنّ، يَدُرْنَ في البلد بالنوائح، ويلطمنَ وجوههن على الحسين بن عليG، ففعل الناس ذلك، ولم يكن للسُنَّة قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة، ولأنَّ السلطان معهم». استفاد الشيعة من هذه الفرصة ليرسّخوا هُويَّتَهم الدينيّة في المجتمع. فأقاموا الخيم في الأسواق وامتنعوا عن شرب الماء، وشاركت النسوة في مراسم العزاء، وقد نثرنَ شعورهنّ وسوَّدنَ وجوههنَّ ومزّقنَ ثيابهنَّ وسِرنَ في الطرق نائحات مولولات ونادبات، ولم يتمكّن السُنّة من مواجهتهم؛ اذ كانت هذه المراسم تجري في ظلِّ دعم معزِّ الدولة، وكان عدد الشيعة أكثر من السُنّة([102]).
في العصر البويهيّ سُمح للشيعة بزيارة مراقد الأئمّة في كربلاء والنجف، بينما كان هذا الأمر ممنوعاً قبل وصول البويهيّين إلى الحكم. وكان الحكّام البويهيّون أنفسهم يزورون كربلاء والنجف.
لقد اتسع نطاق إقامة مجالس التعزية على الحسين في عهد آل بويه، وأحيا هؤلاء الأمراء ورجال السلطة البويهيّة ما كان قد سبق من هذه المناحات وشعارات المآتم، وأضافوا عليها كثيراً، على الرغم من معارضة معظم الخلفاء العبّاسيّين لهم. ولم يقتصر إحياء البويهيّين الذكريات والشعائر على العراق فقط، بل تعدّاه إلى سائر البلدان الإسلاميّة، كمصر وشمال إفريقيا وبعض البلدان العربيّة وايران. لم يكن الأمراء البويهيّون أوّل من أقام المناحة والعزاء والمآتم على الحسين، ولكنّهم كانوا أوّل مَن وسّعوها وأخرجوها من دائرة النواح الضيقة في البيوت والمجالس الخاصّة والنوادي الهادئة وعلى قبر الإمام الحسين بكربلاء إلى دائرة الأسواق والشوارع وتعويد الناس على اللطم على الصدور. استمرّت النياحة على الإمام الحسين واتسعت شعاراتها خلال مرحلة حكم آل بويه في العراق وإيران. والذي بدأ في العام 334هـ وانتهى في العام 467هـ، وسقطت في عهد هذا الحكم السلطة من أيدي العبّاسيّين، ولم يبقَ لهم غير الاسم ؛إذ كانت السلطة الحقيقيّة بيد البويهيّين([103]).
«كان معزّ الدولة البويهيّ في أيام تفوّق البويهيّين وحكمهم في بغداد هو الذي أدخل عادة إحياء الذكرى المؤلمة، فكانت تُغلَق الأسواق ويعطِّل القصابون أعمالهم ويتوقّف الطبّاخون عن الطبخ، وتفرغ الأحواض والصهاريج بما فيها من الماء، وتوضع الجرار مغلقة باللباد في الشوارع والطرق، وكانت تُقرأ في ذلك اليوم المراثي والمناحات»([104]).
وفي عهد معزّ الدولة البويهيّ خرجت مواكب العزاء خارج البيوت، فكانت النساء يخرجن ليلاً، ويخرج الرجال نهاراً حاسري الرؤوس، حفاة الأقدام... تحيتهم التعزية والمواساة بمأساة الحسين([105]).
وجاء في كتاب (قهرمانان إسلام) [أبطال الإسلام] لمؤلّفه عليّ أکبر تشیّد: «وکان معزّ الدولة الديلميّ قد أصرّ بمزاولة عادة إقامة المآتم في يومي التاسوعاء والعاشوراء في بغداد، وصارت الجماعات من القائمين بهذه المآتم تجوب أسواق بغداد، بأعلامها الخاصّة، لاطمة صدورها ورؤوسها. كما أنّ السلطان معزّ الدولة البويهي ّكان يرتدي رداء الحداد والحزن، ويتقدّم عسكره المشترك في هذا المأتم»([106]).
وفي كتاب (تاريخ الإمامين الكاظمين) لمؤلّفه جعفر نقدي: «وكان معزّ الدولة البويهيّ مع وزرائه وأعيان دولته يزور مرقد الإمامين في كلّ خميس، وكان يبيت مع هؤلاء ليلة الجمعة في بيت فخم أعدّه حول المشهد، ثم يرتحل نهار الجمعة بعد تجديد الزيارة إلى محل الحكم»([107]).
وفي (تاريخ الكاظمين) لمؤلّفه ميرزا عبّاس فيض ما ترجمته: «وفي عاشوراء سنة 423هـ/1031م وعلى عهد جلال الدولة البويهيّ، اجتمع لفيف من شباب الشيعة الإماميّة من سكّان الكرخ في مسجد بُراثا وارتقى الخطيب المنبر، وشرع في بيان النهضة الحسينيّة وأسباب قيام الإمام الحسين ضدّ الظلم والبغي والاستبداد، ثمّ سرد فاجعة يوم عاشوراء سنة 61هـ وما جرى على الحسين الشهيد وآله وصحبه، من فتك وقتل وسبي، على يد جلاوزة بني أميّة. ممّا أثار شعور المسلمين وألهب فيهم روح الحماس، وبعد نزول الخطيب عن المنبر تكتّل المجتمعون الذين جاشت عواطفهم في هذا اليوم الفجيع والتحق بهم عدد كبير من سكّان تلك النواحي وساروا نحو المشهد الكاظميّ، لاطمين صدورهم ورؤوسهم، باكين نائحين ومردّدين عبارات الحزن لفاجعة كربلاء من ذلك المسجد حتى انتهوا إلى مشهد الإمامين الكاظمين، وقد أقاموا فيه المناحة والنياحة طيلة ذلك اليوم، ممّا لم يُسبَق له مثيل حتّى ذلك التاريخ»([108]).
جاء في تاريخ (الكامل) لابن الأثير في حوادث العام 422هـ ما نصّه: «زار الملك جلال الدولة، أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه ذات مرّة مشهدَي عليّ والحسين. وكان يمشي حافياً قبل أن يصل إلى كلّ مشهد منهما نحو فرسخ، يفعل ذلك تديّنا...»([109]).
ويقول المؤرّخ الإيرانيّ محمّد بن خاوند شاه بن محمود (ميرخواند) بأنّ معز الدولة أمر في العام 351هـ/962م أن يكتبوا على أبواب مسجد دار السلام: «لعن الله معاوية بن أبي سفيان، ولعن الله من غصب حقّ فاطمة‘، ولعن الله من منع أن يُدفن الحسن عند قبر جدّه|، ومن نفى أبا ذرّ الغفاريّ، ومن أخرج العبّاس من الشورى». وحيث إنّ الخليفة كان محكوماً بحكم معزّ الدولة، فإنّه لم يتمكّن من منع ذلك، وقد مسح البعض في بغداد هذه الكتابات، فأمر معزّ الدولة أن تُكتَب العبارات من جديد، وقد استمرّت الفتنة، بحيث رأى الوزير أبو محمّد المهلّبي أن لا يُلعن أحد غير معاوية، وقد كتبوا هذه العبارة بدلاً منها: «لعن (الله) الظالمين لآل رسول الله|». وبرأي الوزير توقَّفت الفتنة([110]).
ومنذ ذلك التاريخ أُقيمت مراسم عاشوراء بصورة واسعة وإذا صادف يوم عاشوراء يوم عيد النوروز أو عيد المهرجان كان العيدُ يؤجَّل يوماً واحداً. فقد صادف يوم عاشوراء من العام 398 للهجرة يوم عيد المهرجان فأُجّلت مراسم العيد. والجدير بالذكر أنّ البويهيّين كانوا في الظاهر أكثر حرصاً من الفاطميّين على إقامة مراسم العزاء في يوم عاشوراء، وإعطاء صفة رسميّة له. وأقام الفاطمیّون مراسم عاشوراء في مصر، وخلال حكومة المعزّ لدين الله (360هـ/970م) شارك المصريّون في مراسم عاشوراء وأقاموا المآتم والتعازي بهذه المناسبة([111]).
ويرى الباحث حسن منيمنة بأنّ سياسة البويهيّين مع الأطراف الداخليّة أو الخارجيّة، كانت محكومة بمصالحهم السياسيّة وليست الدينيّة، لذلك فإنّ انتقالهم المحتمل من المذهب الزيديّ الذي كان منتشراً بين الديلم عند بدايات ظهور الأسرة البويهيّة إلى المذهب الاثني عشريّ كان مدفوعاً بمصلحتهم السياسيّة؛ إذ كان لزاماً عليهم لو كانوا زيديّين، أن يتركوا الحكم لأحد العلويّين، فكان من الأيسر لهم أن ينتسبوا إلى العقيدة الاثني عشريّة التي تقول بغيبة الإمام، ولحين عودته تكون السلطة الفعليّة ملكاً لا نزاع فيه لمن يستولي عليها، شريطة أن ينافح عن قدسيّة الإسلام([112]). ويقصد منيمنة أنّ البويهيّين كانوا يقيمون العزاء على الحسين من أجل أن يثبتوا أنّهم شيعة، ويعتقد الباحث أنّ كلّ ما قام به البويهيّون كان هدفه أن يظهروا أنفسهم بأنّهم شيعة وليسوا على المذهب الزيديّ. ويبدو أنّ هذا الحكم الذي أطلقه الباحث على البويهيّين يجافي الحقيقة، وبعيد عن الواقع.
ويوحي منيمنة بأنّ البويهيّين الذين التزموا بالمذهب الاثني عشريّ لم يكونوا مؤمنين به، بل كانوا يهدفون من وراء ذلك البقاء في الحكم، وأنّ ما قاموا به خلال حكمهم كان لا ينطلق من إيمانهم بالمذهب الشيعيّ، وإنّما كان ذلك من أجل التشبُّث بالحكم. وهذا الادعاء لا يمكن الأخذ به؛ لأنّ إعلان يوم عاشوراء يوم عزاء من جانب البويهيّين لم يكن يهدف إلى إرضاء الشيعة بقدر ما كان ينطلق من إيمانهم بهذا المعتقد. وكان حرصهم على زيارة مراقد الأئمّة ولا سيّما مرقد الحسين والإمام عليّ ومرقد الإمامين الكاظمين في الكاظميّة لا يمكن أن يكون من أجل مصلحة سياسيّة أو للتظاهر أمام الشيعة.
ظهور طبقة النائحين في القرن الثالث الهجريّ
ظهر في القرن الثالث للهجرة في العراق، طبقة النائحين أو النادبين الذين كانوا يقرأون المراثي على الحسين، وسمّوا بالنائحين ومفرده نائح ونائحة. وكان النائحون يقرأون أشعاراً لشعراء أهل البيت، ومنهم دعبل الخزاعي والناشئ الصغير. وعقدت مجالس سُمِّيت باسم (مجالس النياحة على الحسين) فكان النائح يقرأ قريضاً ينشئه([113]). ومن أشهر النائحين أو النادبين في العراق، ابن أصدق([114]). ونقل المفيد في أماليه أنّ «درّة النائحة رأت فاطمة الزهراء فيما يرى النائم، وأنّها وقفت على قبر الحسين تبكي وأمرتها أن تنشد:
|
أيّها العينان فيضا واستهلّا لا تغيضا |
وبسبب القمع الذي تعرّض له الشيعة في بغداد على يد الحنابلة، كان الناس لا يستطيعون النياحة على الحسين×. ومن كان ينوح على الحسين كان يتعرّض للقتل والقمع. وكانت في بغداد نائحة مجيدة حاذقة تُعرَف بخِلب، تنوح بقصيدة الناشئ([116]) مطلعها:
|
أيّها العينان فيضا |
فبلغ ذلك البربهاريّ، وهو أبو محمّد الحسن بن علي بن خلف أحد علماء الحنابلة في بغداد في أوائل القرن الرابع الهجريّ، وعُرف بعدائه للشيعة، ولمن كان يقرأ المراثي على الحسين، أو من يزور مرقد الحسين في كربلاء([117]). وقد قال البربهاري: بلغني أنّ نائحة يقال لها: خِلْب، تنوح، اطلبوها فاقتلوها»([118]).
ومع أنّ النياحة على الحسين لم تكن تستهدف التعرّض لأعداء أهل البيت، إلّا أنَّ الشيعة كانوا يخافون الحنابلة، وكانوا لا يتجرّأون على النياحة بصورة علنيّة([119]).
فالمنشدون وقرّاء المراثي الذين كانوا يقرأون أشعاراً في رثاء الإمام الحسين× كانوا يواجهون دائماً نفراً يمنعونهم قراءة المراثي، بل كان هؤلاء يهدِّدون قرَّاء المراثي بالعقاب والقتل.
إقامة العزاء الحسينيّ في القرنين الخامس والسادس الهجريّين
استمرّ الشيعة في إقامة العزاء الحسينيّ بعد عصر آل بويه، بل إنّ المراسم توسَّعت كثيراً ولم يوقِف الشيعة إقامة مراسم العزاء، مع أنّ السُنّة كانوا يواجهونهم، وكانت تُدار مناقشات دينيّة بين الجانبين، وكانت تؤدّي في بعض الأحيان إلى اشتباكات دمويّة. مع أنّ دخول الأتراك السلاجقة إلى الأراضي الإسلاميّة دَعَمَ السُنّة وضيّق الخناق على الشيعة، إلّا أنّ مراسم العزاء لم تُنسَ بل زادَ ذلك بتقادم الأيام، وأصبح العديد من أهل السُنّة (الشافعيّة والحنفية) من عشّاق هذه المراسم، ويمكن ذكر ما كتبه صاحب كتاب (النقض) كمصداق على ذلك.
يتحدّث عبد الجليل القزوينيّ الرازيّ صاحب كتاب (النقض) عن انتشار مراسم العزاء عند الشيعة في القرن الخامس والسادس الهجريّين. ويقول ردّاً على أحد المجبِّرة الذي كتب يقول «هذه الطائفة (الشيعة) يظهرون الجزع والحزن يوم عاشوراء، ويمزِّق عامّة الناس ملابسهم، وتلطم النساء صدورهنّ وينتحبنَ»، إنَّ هذا الكلام يدلّ على بغض آل الرسول؛ لأنّ الجميع يعلم بأنّ (الإمام المقدّم أبو حنيفة) و(الإمام المكرّم الشافعيّ) والعلماء والخلفاء والطوائف خلفاً عن سلف كانوا يحيون سنّة التعزية، (مثلما نظم الشافعيّ مراثي كثيرة في الحسين وشهداء كربلاء). وعلاوة على ذلك، فإنّ مراثي أصحاب أبي حنيفة والشافعيّ في شهداء كربلاء كثيرة ولا نهاية لها([120]).
ويذكر الرازيّ أيضاً: أنّ أعيان وأشراف أهل السُنّة أقاموا مراسم عاشوراء وشاركوا في العزاء والنياح. ويذكر على سبيل المثال الخواجة علي الغزنويّ الحنفيّ في بغداد. «إنّه أقام التعزية، وبالغ في لعن آل سفيان يوم عاشوراء». وفي همدان التي كانت مأوى جيش الترك ومأمنهم، «أقام مجد الدين مُذكّر الهمدانيّ العزاء في موسم عاشوراء بحيث جعل أهالي قم يندهشون منه»([121]).
إنّه يتحدّث عن نيسابور والخواجة الإمام نجم أبي المعالي بن أبي القاسم بزاري، ويقول «مع أنّه كان حنفيّ المذهب إلّا أنّه كان يقيم العزاء بكلّ قوة، وكان يأخذ كتاباً بيده ويقرأ التعزية، وينثر التراب على رأسه، ويطلق الصرخات والعويل»([122]).
في مدينة الريّ كان الشيخ أبو الفتوح نصر آبادي، والخواجة محمود حدادي حنفيَّي المذهب «فقد فعلا ما فعلاه في يوم عاشوراء من ذكر العزاء ولعن الظالمين وذلك في نزل كوشك والمساجد الكبرى». «والقاضي عمده ساويي الحنفيّ الذي كان من أهل الحديث معروفاً، وقد روى هذه القصّة في جامع طغرل بحضور عشرين ألف إنسان وأقام العزاء وحَسَرَ رَأسَهُ، وشقّ جَيْبهُ، ولم يفعل أحد ما فعله في هذا اليوم»([123]).
بعد مجلس الشهادة كان المشاط يتحدّث عن مقتل عثمان وعليّ× في كلّ عام وفي كلّ شهر محرّم ويوم عاشوراء، وكان يصل إلى مقتل الحسين بن علي. «وقد تحدّث في عام بحضور الأميرات والخاتون [زوجة] أمير واقعة كربلاء، وقد مزّق الحاضرون ثيابهم، وعفّروا وجوههم بالتراب»([124]).
إذاً كان الجميع في العالم الإسلاميّ ـ سواء كان سُنّیاً حَنفيّاً أو سنّيّاً شافعیّاً أو شيعيّاً ـ يقيم العزاء على الحسين×، ويظهر البكاء والجزع عليه وعلى شهداء كربلاء.
كان لسقوط الخلافة العبّاسيّة آثارٌ إيجابيّة على الشيعة؛ اذ كان العبّاسيّون يضيّقون
عليهم، وكانت خطوات غازان خان([125]) في الدولة الإيلخانيّة تعود بالنفع على الشيعة. كان غازان خان يكنّ احتراماً لأهل البيت ولآل عليّ ؛لأنّه رأى ذات ليلة رسول الله| والإمام عليّ والحسن والحسين في المنام، وقد حظِي بلطفهم وعطفهم، ولهذا السبب زار غازان خان الأماكن المقدّسة في الكاظميّة والنجف الأشرف وكربلاء، وخصّص نذورات وصدقات وأوقافاً كبيرة لهم. وقد استفاد الشيعة من موقفه منهم بأن زادوا من المراسم الدينيّة، ولا سيّما في عاشوراء، وأقاموا العزاء بهذا اليوم بكلّ ما أُوتوا من قوّة. وكانت خطوات غازان خان قد جعلت صحراء كربلاء تتحوّل إلى أراض زراعيّة، وحفر نهر غازان لمدّ الأراضي الزراعيّة بالماء، وتحوّلت الأماكن المحيطة بضريح الإمام الحسين إلى مزارع وبساتين([126]).
وفي القرن السادس للهجرة كان الشافعيّون والأحناف يشاركون في مراسم عزاء الحسين، وكانت تقام مراسم خاصّة بهذا الشأن. وبمرور الوقت ازدادت هذه المراسم تأثيراً واستحكاماً. وقد وصف لنا القزوينيّ الرازيّ ما رافق العزاء على الحسين من جزع وبكاء وعويل، وشقّ للجيوب، ولطم الوجوه، وتعفير الوجوه وقراءة المراثي، ولعن آل سفيان والظالمين، وصبِّ التراب على الرؤوس، وإطلاق الصيحات وكشف الرؤوس.
وكان تشيّع شقيق غازان اولجايتو ـ السلطان محمّد خدابنده([127]) ـ فرصة للشيعة ليوسّعوا مراسمهم، ولكنّ المصادر لم تتحدّث عن كيفيّة إقامة العزاء أيام عاشوراء، ولكنَّ خطوات الأخوين أشارت إلى أنّهما لم يدّخرا جهداً في نشر التشيّع في المجتمع، ويبدو أنّ مراسم عزاء الحسين كانت تقام بكلّ قوة. وكان لحضور العلماء الشيعة مثل الخواجة نصير الدين الطوسيّ، والعلّامة ابن مطهر الحليّ، وابن طاووس الحليّ وفخر المحقّقين وتاج الدين أوجي في المناصب الحكوميّة العليا قد سمح للشيعة في إظهار عقائدهم، وإقامة مراسم العزاء أيام شهر محرم.
وكانت مدينة حلب مركزاً للشيعة؛ حيث كانوا يقيمون مراسم الحزن على الحسين يوم عاشوراء، وهذا ما أشار اليه الشاعر جلال الدين الرومي في ديوانه (المثنوي المعنوي). وذكر الشاعر جلال الدين الروميّ بأنّ أهل حلب كانوا يتجمّعون يوم عاشوراء في باب أنطاكيا وكانوا يقيمون مراسم العزاء على الحسين ابن علي وشهداء كربلاء([128]).
العزاء الحسيني في عهد الصفويّين والعثمانيّين في العراق
«عندما تولّى الصفويّون السلطة في إيران وسيطروا على العراق كان الإقبال على إقامة المآتم والنياحات عظيماً، وكانت حريّة الشيعة في إحياء هذه الذكرى مضمونة. وغالى الشيعة في إقامتها، ولكن عندما قويت سلطة الحكومة العثمانيّة وقع الضغط على الشيعة، ومُنعوا عن إقامة المناحات ومزاولة شعائرهم التقليدية فيها، الأمر الذي كان يضطرهم إلى إقامتها وإحياء ذكرياتها سرّاً وداخل البيوت، وفي سراديب الدور، وتحت طائلة الخوف والجزع والتقيّة»([129]). وفي عهد الشاه إسماعيل الصفويّ، أُعلن المذهبُ الشيعيّ في إيران والعراق مذهباً رسميّاً للحكومة الصفويّة، وكذا على عهد السلاطين العثمانيّين كالسلطان سليمان القانوني المتوفّى في العام 941هـ الذي زار كربلاء والنجف، وكذا على عهد الأمراء الشيعة الآخرين، الذين حكموا بعض أنحاء العراق كدولة بني مزيد في الحلّة وبني شاهين في البطيحة، وبني حمدان وآل المسيب في الموصل ونصيبين([130]).
وقد أسرف بعض الحكّام العثمانيّين في معاداة الشيعة، ومنهم السلطان مراد الرابع الذي أسرف في قتل الشيعة وسفك دمائهم، وأحرق كتبهم وقام بتعذيبهم، فقد مُنعت إقامة المآتم على الحسين، وطُورد القائمون بها، بَيدَ أنّ من خلفه من السلاطين أطلقوا بعض الحريّة للشيعة في إحياء ذكريات الحزن على الحسين، وإقامة شعائرهم، بمختلف المظاهر، ومتنوّع التقاليد التي درجوا عليها وتعوّدوا على إقامتها سرّاً ثمّ علناً منذ العهدين الأمويّ والعبّاسيّ، وإنّما كانوا يقيمونها تحت الستار والتقيّة([131]).
ويقول الشيخ محمّد مهدي شمس الدين في كتابه (ثورة الحسين) عن موقف العثمانيّين من مجزرة كربلاء: «لاحقَ العثمانيّون هذه المآتم ومنعوا إقامتها في أحيان كثيرة، فكانت تقام سرّاً. وفي ما بعد العثمانيّين، لُوحِقت هذه المآتم ثم منعتها السلطة في بعض الأحيان، وقيَّدتها بقيود كثيرة ثقيلة في أحيان أخرى؛ لأجل إفراغها من محتواها النقدي للسلطة القائمة»([132]).
تعرَّض الشيعة في العراق إلى هجوم القوّات الوهّابيّة السعوديّة التي هاجمت مدينتي كربلاء والنجف في العام 1802هـ كما هاجمت مدينة البصرة العراقيّة وقتلت سكّان المدينتين، وهدمت مرقد الحسين ونهبت كلّ ما كان فيه.
لقد ترك هجوم الوهابيّين على كربلاء والنجف في العام 1802م، وكذلك على البصرة آثاراً كبيرة على الشيعة في العراق، وعلى تطوّر العزاء الحسينيّ، حيث ألهبت هذه الحوادث حماس الخطباء والشعراء، وألهمتهم خطباً وقصائد لا تُحصى ولا تُعدّ من قصائد العزاء والمراثي، التي عبّرت مضامينها عمَّا جرى ويجري للشيعة من آلام ومآسٍ وما شعروا به من غضب شديد. «وكان بعض الشعراء قد وصفوا ما حدث بأنّه كان يماثل ما جرى في واقعة كربلاء من قتل وتشريد، بل إنّ هذه الحادثة هي إعادة لمأساة كربلاء من جديد»([133]).
وحاول الوالي المملوكيّ في العراق داود باشا([134]) التضييق على الشيعة، ومنعهم من إقامة العزاء الحسينيّ، لاعتقاده بأنّ العزاء الحسينيّ هو إحدى وسائل الدعاية التي تقوم بها الدولة الإيرانيّة لإفشال مخطّطاتهم وإسقاط الدولة العثمانيّة. واضطر شيعة العراق حينذاك إلى إقامة مجالس التعزية في السراديب (تحت الأرض) بعيداً من العيون والأسماع، كما اضطروا إلى ترك امرأة تدير الرحى في صحن الدار لكي لا يسمع المارّة في الشارع صوت من يقرأ أو من يحضر مجلس العزاء([135]).
وبعد انعقاد اتفاق صلح بين داود باشا والحكومة الإيرانيّة في العام 1821م، أقام العراقيّون مجالس التعزية بصورة علنيّة، وكان أوّل مجلس تعزية أُقيم في النجف في بيت الشيخ محمّد نصار النجفيّ، وتطوّر تدريجيّاً. وبعد الإطاحة بحكم المماليك في العراق وسقوط داود باشا في العام 1831م وتعيين عليّ رضا والياً على بغداد، أخذ العزاء الحسينيّ بالانتشار، ووعد الوالي شيعة العراق بالسماح لهم بإقامة مجالس العزاء وكان هو يحضر هذه المجالس.
وأشار السيّاح الأجانب الذين زاروا العراق خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر في مذكّراتهم إلى مراسم العزاء الحسينيّ، التي كانت تجري في كربلاء والنجف، ولم تقتصر إقامة مجالس العزاء في البيوت فحسب، بل امتدّت إلى المساجد والمدارس الدينيّة وحتى أضرحة الأئمّة.
نشأة مواكب العزاء في العصر الحديث
في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر، أخذت مجالس العزاء بالانتشار في العراق، ونشأت مواكب العزاء الحسينيّ، وهي مسيرات شعبيّة للاحتفال بذكرى استشهاد الحسين، وكان أوّل المواكب (موكب اللطم) أو (اللطّامة) الذي يتكوّن من مجموعة أو مجموعات من الرجال، يضربون بأيديهم على صدورهم المكشوفة. ومن المحتمل أن يكون موكب الشيخ محمّد باقر أسد الله (المتوفّى في العام 1840م) في الكاظميّة من أوائل تلك المواكب([136]).
«كان آية الله الشيخ محمّد جواد البلاغيّ (المتوفّى في العام 1846م) أوّل من أقام المواكب الحسينيّة يوم عاشوراء، في كربلاء، وعنه أخذت حتّى توسّعت ووصلت إلى ما هي عليه اليوم»([137]).
استمرّت الاحتفالات بذكرى عاشوراء في العراق خلال حكم الولاة العثمانيّين الذين جاءوا بعد علي رضا باشا، غير أنّ الوالي العثمانيّ مدحت باشا الذي حكم العراق بين العامَين 1868 ـ 1871م، حاول منع مواكب العزاء في شهر محرّم، «وأصدر مرسوماً في محرّم العام 1869 يمنع فيه إقامة مسيرات المواكب وهدّد بمعاقبة كلّ من يقيم مجلس عزاء. وقد وجد مدحت باشا نفسه مضطرّاً إلى إلغاء ذلك المنع في العام الذي تلاه، بعد أن استشار الباب العالي في إسطنبول»([138]).
انتشرت الاحتفالات بذكرى استشهاد الحسين في العراق في القرن العشرين، واتخذت طابعاً فولكلوريّاً شعبيّاً في المدن المقدّسة، في الكاظميّة وكربلاء والنجف، وكذلك في بغداد والبصرة، فإلى جانب مجالس التعزية، أُقيمت مواكب اللطم على الصدور وضرب السلاسل الحديديّة (الزناجيل)، وكذلك تمثيل واقعة الطفّ ومقتل الإمام الحسين.
وبعد الاحتلّال الإنجليزيّ للعراق في العام 1917م، اتبع الإنجليز سياسة التحبيب والترغيب تجاه مجالس التعزية، وأخذوا برعاية المواكب الحسينيّة وأحاطوها بالعناية والحماية، وأمدّوها بما تحتاج من موادّ كانت نادرة آنذاك مثل النفط لكسب العامة إلى جانبهم والالتفاف حولهم.
وهذا التزلُّف إلى الشيعة لم يقف حائلاً دون الثورة التي انطلقت من الحوزات العلميّة في وجه البريطانيّين.
بعد تأسيس المملكة العراقيّة في العام 1921 أعلنت الحكومة العراقيّة يوم عاشوراء ـ وهو اليوم العاشر من شهر محرّم من السنة الهجريّة ـ عطلة رسمية لأوّل مرّة، كما سُمح بإقامة مراسم العزاء الحسينيّ تكريما لذكرى استشهاد الإمام الحسين.
وفي يوم عاشوراء من العام 1927 حدثت صدامات عنيفة بين مواكب العزاء وجنود الحكومة في صحن الكاظميّة سقط على أثرها أربعة قتلى، وجرت الاحتفالات في السنوات اللاحقة من دون حوادث تذكر.
وفي العام 1928، حاولت الحكومة العراقيّة منع إقامة المواكب الحسينيّة والتضييق عليها، غير أنّ المنع والتضييق رُفع في السنة التالية، حيث خرجت المواكب الحسينيّة مرّة أخرى، ومواكب التطبير بالسيوف، ومواكب ضرب السلاسل الحديديّة (الزناجيل).
اهتمّ الملك فيصل الأوّل باحتفالات عاشوراء، وقدّم لمواكب العزاء بعض المساعدات الماليّة، وحضر الملك فيصل بنفسه مجلس التعزية أكثر من مرّة.
في العام 1932 قامت الحكومة بالتضييق على مواكب العزاء، ومنعت مواكب الكاظميّة من أداء مراسمها، مما دفع أهالي الكاظمية إلى التوجّه إلى كربلاء وإقامة مراسم العزاء فيها. وفي العام 1935 حاول ياسين الهاشمي منع مواكب العزاء وإلغاءها؛ لأنّها أحد العوامل التي وقفت وراء انتفاضة عشائر الفرات الأوسط في العراق العام 1935([139]).
خلال الخمسينات من القرن العشرين فرضت الحكومة العراقيّة مجدّداً قيوداً مشدّدة على مواكب العزاء الحسينيّ، ولا سيّما مواكب التطبير في البصرة، وأجبرتهم على الحصول على ترخيص من الشرطة، وقد ساعد على انحسار مواكب التطبير دعوة بعض العلماء إلى ضرورة تهذيب مراسم العزاء الحسينيّ من بعض الممارسات التي لا تليق بشأن العزاء الحسيني.
بعد قيام ثورة 14 تموز 1958 أصدر عبد الكريم قاسم مرسوماً يمنع فيه إقامة مواكب التطبير بالسيوف فقط، غير أنّ المطبِّرين أقاموها خارج مراكز المدن، لكنّ نهاية الستينات وبداية السبعينات مثّلت نقطة تحوّل في تاريخ مراسم العزاء الحسينيّ، حيث أخذت الاحتفالات بالتطوّر والازدهار والانتشار بشكل واسع في العام 1968م، وقد أظهرت الحكومة العراقيّة تسامحاً مع مراسم العزاء الحسينيّ.
في العام 1975 أخذت السلطات المحليّة، تشدّد الخناق على الشعراء والخطباء والرواديد، وإجبارهم على إدخال بعض مبادئ حزب البعث العربيّ الحاكم في الخطب والقصائد وتقديم الولاء للسلطة. في العشرين من صفر من العام 1396هـ/ ك2/يناير 1976م قامت الحكومة بمنع مسيرة شعبيّة من النجف إلى كربلاء ليلة الأربعين، وفي العام التالي قامت السلطات المحليّة ثانية بمنع المسيرة ليلة الأربعين، خشية أن تتحوّل إلى تظاهرة جماهيريّة واسعة تشكّل في النهاية خطراً على السلطة، ولكنْ على الرَّغم من قرار المنع، انطلقت مجموعة من الشباب والفتيان في مسيرة متوجّهة إلى كربلاء، وسرعان ما توسّعت المجموعة وتحوّلت إلى مسيرة شعبيّة وصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ألف شخص، ردّدوا شعارات سياسيّة ضدّ السلطة الحاكمة. وتوجّه المتظاهرون إلى أحد مراكز الشرطة واحتلّوه، وأخذ بعض المتظاهرين بتحطيم كلّ ما وجدوه أمامهم، ثمّ واصلوا مسيرتهم نحو كربلاء، حيث واجهوا الجنود والدبابات وأفراد الجيش الشعبيّ، وقد استخدمت قوّات الجيش القنابل المسيّلة للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، ثمّ استخدم الجيش البنادق والرشاشات، كما قامت طائرات الهليكوبتر بالإغارة على المتظاهرين وسقط إثر ذلك عدد من القتلى والجرحى واعتقلت السلطات المحلّيّة مئات الأشخاص، وصدرت في حقّ عدد كبير منهم أحكام بالإعدام، وحُكم على عدد آخر بالسجن المؤبّد. كما أُلقي القبض على عدد من العلماء والمجتهدين في النجف، كان على رأسهم السيّد محمّد باقر الصدر([140]) في 19 جمادي الأولى سنة 1400هـ وأُعدم مع أخته بنت الهدى في سجون النظام في 22 جمادى الأولى من السنة نفسها.
تشهد كربلاء والمدن العراقية والكثير من البلدان الإسلاميّة في الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم من كلّ عام خروج مواكب اللطامة إلى الشوارع والميادين. مردّدين شعارات أو ردّات في رثاء الحسين×([141]). كما إنّ موكب الزناجيل هو النوع الثاني من المواكب الشعبية التى تتكوّن من مجموعة أو عدّة مجموعات من الرجال الذين يضربون بالسلاسل الحديديّة على الظهر والكتفين كطقس عزائيّ من أهدافه تقديم المواساة في شهر محرّم من كلّ عام.
وفي كثير من الأحيان، يتضمّن موكب الزناجيل موكب الشبيه، أي أنّ رجالاً يلبسون ملابس خضراء تمثّل الحسين وأهل بيته، وقادة جيش يزيد بن معاوية يلبسون ملابس باللون الأحمر والأصفر يركبون الخيول ويقومون بتمثيل معركة كربلاء، حيث يقاتل الحسين أعداءه من أنصار يزيد بن معاوية. كما توضع الهوادج على الجمال، وتوضع فيها النساء والأطفال، والتي تمثِّل أسْرَ نساء الحسين وأهل بيته من قبل جيش يزيد، ونقلهم بعد معركة كربلاء إلى الكوفة، ومن ثَمَّ إلى الشام.
كما تخرج صبيحة العاشر من المحرم مواكب التطبير في المدن العراقية المقدسة([142]). والتطبير هو جرح الرؤوس الحليقة بالسيوف والقامات، وهو طقس شعبيّ يعبّر بحسب رأيهم، عن المشاركة في إيذاء النفس والجسد؛ مواساة للإمام الحسين الذي قتل مثخناً بالجراح في معركة الطف بكربلاء.
وعلى إيقاع الطبول والأبواق وهتافات الجماهير ترتفع الضربات على الرؤوس بوتائر سريعة حتى تصل إلى ذروتها، حين يأخذ البعض بالضرب على رأسه بقوّة، بحيث تُحدِث شرخاً في الرأس ينزف دماً غزيراً، وقد يسقط البعض منهم على الأرض مغشيّاً عليه، وقد حدث أن توفّي البعض منهم على إثر تلك الضربات.
منعت الحكومات المتعاقبة في العراق التطبير، لا سيّما بعد تولّي حزب البعث الحكم، إلّا أنَّ هذا التقليد استمرّ بعد سقوط حزب البعث في العراق، ولا يزال التطبير مستمرّاً حتى عصرنا الحاضر. علماً أنّ علماء كبارا في العراق وإيران ولبنان قد حرَّموا التطبير، ونصحوا الناس بالتوجّه إلى المراكز الطبيّة للتبرّع بالدم.
خلاف حول بعض مظاهر العزاء الحسينيّ
منذ خروج مواكب العزاء إحياءً لذكرى استشهاد الحسين بن علي في البلدان الإسلاميّة والخلاف محتدمٌ بين العلماء الشيعة حول جواز أو تحريم بعض مظاهر العزاء الحسينيّ، ولا سيّما خروج مواكب التطبير في المدن الشيعيّة ومنها كربلاء. وقد عدّ بعض العلماء خروج مواكب التطبير في المدن الشيعيّة وهناً ومنقصّة لعزاءالإمام الحسين وتشويهاً لسمعة الشيعة في العالم.
وقد اختلف العلماء الشيعة حول کیفیّة إقامة مراسم عاشوراء ولا سيّما تسيير موكب الضاربين؛ أي التطبير فمنهم من حرّمه ومنهم من أجازه، ولا زال الخلاف بين العلماء مستمرّاً حتى عصرنا الحاضر، فكم من الكتب والرسائل كُتبت حول جواز أو تحريم التطبير منذ عدَّة قرون. وقد منعت الحكومات المتعاقبة في العراق وإيران خروج مواكب التطبير، ولا سيّما أيام حكومة حزب البعث؛ حيث كان النظام يحارب هذه المواكب وكلّ المواكب التي كانت تخرج أيام شهر محرّم.
وفي لبنان حصل خلاف كبير بين علماء الدين وعلى رأسهم السيد محسن الأمين([143]) الذي كتب عدّة كتب منها: (إقناع اللائم على اقامة المآتم) ورسالة (التنزيه لأعمال الشبيه) و(المجالس السنيّة في مناقب ومصائب العترة النبوية) حرَّم فيها ضرب الرؤوس أي التطبير، بينما أصدر عالم آخر وهو الشيخ عبد الحسين الصادق([144]) كتاب (سيماء الصلحاء) أجاز فيه التطبير وهاجم السيدَ الأمين.
عندما جاء السيّد محسن الأمین الی الشام رئیساً دينيّاً قاطع عاشوراء في مرقد السيدة زينب (في العاصمة السورية دمشق)، وقاطعه وجهاء الطائفة ونخبتها في الشام، بل أقام هو مع مريديه مراسم تقتصر على تلاوة قصّة واقعة كربلاء، مع شرح المعاني السامية التي ترمز إليها وتدلّ عليها تلك الواقعة الخالدة. أمّا العامّة فقد واصلوا إقامة عاشوراء في السيّدة زينب على الكيفيّة المذكورة آنفا مع القادمين من الخارج، ولا سيّما من لبنان والعراق وإيران. ولكنّ السيد الأمين لما استقرّ في الشام، وأمكنته إقامته فيها من الاتصال بالخاصّة والعامّة من شيعتها، قرّر منع إقامة عاشوراء في السيّدة زينب على تلك الكيفيّة، ومنع شيعة الشام عامّة من الاشتراك فيها. وهكذا مُنِعت إقامة عاشوراء في السيّدة زينب بتاتاً.كان ذلك في العهد التركيّ وكان ذلك قبل صدور كتاب (رسالة التنزيه)([145]).
غير أنّ السيد الأمين لم يكتفِ بمنع إقامة عاشوراء على تلك الكيفيّة العنيفة، بل قرّر أن يقيم مكانها البديل؛ إذ لا يكفي الاكتفاء بالمنع فقط. فأصدر لهذا الغرض (المجالس السنيّة) التي صدرت طبعتها الأولى في العام 1923م في مطبعة الترقّي في دمشق. وقد أثار هذا الكتاب ضجيجاً في العراق؛ نظراً لما تضمّنه من تحريم التطبير والتمثيل والتشبيه، داعياً إلى التمثيل الخالي من المحرّمات والبكاء والحزن لمصاب الحسين([146]).
وقبل صدور كتاب (رسالة التنزيه) في العام 1364هـ/ 1928م، سُئل السيّد الأمين رأيه في اللطم على الصدور والضرب على الرؤوس فأجاب بالتحريم، ممّا أثار الشيخ عبد الحسين صادق، فأصدر رداً على هذا التصريح للسيّد الأمين في رسالة دعاها: (سيماء الصلحاء)([147]).
انقسم علماء الدين الشيعة بين مؤيّد للسيد الأمين ومعارض له، كما أيّد جمع من العلماء الشيخ عبد الحسين الصادق في إقامة طقوس العزاء على الحسين. واستمرّ الجدل سنوات طويلة بين الجانبين. وأدخل القائمون على مراسم عاشوراء في النبطيّة المسرح الحديث إرضاءً لمتطلّبات التقدّم وبقي الضرب على الرؤوس بالسيوف واللطم على الصدور مظهراً عنيفاً يدعو الناس إلى الحضور بكثافة لمشاهدة تمثيل واقعة كربلاء([148]).
وقد أورد السيّد محسن الأمين في كتابه (المجالس السنيّة في مناقب ومصائب العترة النبويّة) رأيه المعارض لهذه الممارسات بقوله: «إنّ ما يفعله جملة من الناس من جرح أنفسهم بالسيوف أو اللطم المؤدّي إلى إيذاء البدن، إنّما هو من تسوّلات الشيطان وتزيينه سوء الأعمال، فذلك ممّا يغضب الحسين×، ويبعّد عنه، لا ممّا يقرّب إليه، فهو× قد قُتل في سبيل الإحياء لدين جدّه|، وهذه الأعمال ممّا نهى عنها دين جدّه، فكيف يرضى بها، وتكون مقرّبة إليه تعالى، والله تعالى، لا يُطاع من حيث يعصى، كما ذكرنا آنفاً. وانتحال بعض الجهال عذراً لذلك بما ينقلونه من أنَّ إحدى الطاهرات نطحت جبينها بمقدَّم المحمل حتى رُئي الدم يجري من تحت قناعها، هو من هذا البحر، وعلى هذه القافية التي مرّت الإشارة إليها، وهكذا ما يجري من التمثيل والتشبيه للواقعة فإنّه في نفسه مشتمل على كثير من المحرّمات، وموجب لهتك الحرمة، وفتح باب القدح. نعم التمثيل الخالي من المحرّمات والشائنات لا بأس به، ولكن أين هو؟!. فعلى من يريد التقرّب إلى الله تعالى ونبيه| وأوليائه بالبكاء والحزن لمصاب الحسين×، أن لا يتعدّى ما رسمه الرضا نقلاً عن أبيه÷ في قوله: ولا تكونوا شيناً علينا، وإلّا كان من الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعاً»([149]).
فضلاً عن مخالفته للتطبير أعلن السيّد محسن الأمين عن «معارضته لضرب الظهور بسلاسل الحديد، واستعمال آلات اللهو كالطبل والزمر (الدمام) والصنوج النحاسيّة والتلحين بالغناء، وتشبّه الرجال بالنساء، وصياح النساء على مسمع الرجال الأجانب عدا ذلك ممّا يسوّل به إبليس، ومن المنكَرات التي تُغضب الله ورسولَه| وتغضب الحسين×، فإنّه إنّما قتل في إحياء دين جدّه| ورفع المنكرات فكيف يرضى بفعلها لا سيّما إذا فعلت بعنوان أنّها طاعة وعبادة»([150]).
وكان تحريم بعض العلماء الشيعة للتطبير قد أثار جدالاً كبيراً بين أنصار من يحلّلون التطبير ومن يحرّمونه وتعرّض السيّد محسن الأمين لحملة شعواء من معارضيه، ونُشرت كتب ورسائل تردُّ عليه.
وبعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران، أُعلن حظر التطبير، ومُنع القائمون عليه من تسيير المواكب. ولكنَّ مواكب التطبير كانت وما تزال تخرج في إيران سرّاً، وفي العراق تخرج مواكب التطبير علناً بعد سقوط نظام الطاغية صدام الذي كان قد منع العزاء على الحسين، وفرض عقوبات كبيرة على من يقيمها.
ورداً على الذين يأخذون على الشيعة أنّهم يقيمون المستحبات في طريق الحرام يقول بعض العلماء: «إذا لم يلحق التطبير الأذى بالإنسان فإنّه لا يكون حراماً لأنّ ذلك لا تشمله الآية الكريمة (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) و( المؤمن لا يقتل نفسه). ویردّون على من يعدّ التشابيه حراماً بالقول: التشبيه ليس حراماً وليس عملاً شائناً، وليس تشبّهاً بالأعداء، فالتشبيه بأولياء الله ليس حراماً، بل إنَّه يعرّف أولياء الله لعباده ويُبيّن مظلوميّتهم»([151]).
لا يغيبنّ عن البال، أنَّ العزاء هو أحد وسائل الإعلام في عصر لم يكن لوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفزة أيّ وجود خارجيّ. وكانت مجالس العزاء تهدف إلى التثقيف الدينيّ لمجموعة من الناس الأميّين وغير المتعلمين، الذين كانوا يحضرون مجالس العزاء، وكانوا يتلقّون أخبار نهضة الحسين، ويحملون أهدافه التي استُشهد من أجلها.
ولا ننسى أنَّ الأئمّة من أهل البيت^ كانوا يشجّعون الشيعة على إقامة مجالس العزاء، وإلقاء القصائد من جانب الشعراء، وهم يعلمون أثر تلك المجالس والأشعار في إحياء ذكرى عاشوراء منذ استشهاد الحسين في القرن الأوّل الهجريّ وحتى القرن الحاليّ.
كانت مجالس العزاء تعلّم الناس العاديّين مبادئ ثورة الحسين، وترسّخ في أذهانهم حبّ أهل البيت وتبيّن لهم تضحياتهم وتفانيهم من أجل نشر الدعوة الإسلاميّة بعد أن حاول العديد من الحكام، ولا سيّما خلفاء بني أميّة وبني العبّاس تحويل الخلافة إلى ديكتاتوريّة وراثيّة مطلقة تحكم الشعوب، من دون أنْ يكون لهذه الشعوب أيُّ دور في إدارة نفسها والمشاركة في الحياة السياسيّة.
فتاوى علماء الدين في العراق حول طقوس العزاء
تشعّبت وتوسعّت مراسم العزاء على مرّ العصور والازمان، ودخلت إليها مراسم وطقوس خاصّة أثارت ردود أفعال ليس فقط بين علماء المذاهب الإسلاميّة بل بين علماء الشيعة أنفسهم. ولعلماء الدين الشيعة وجهات نظر مختلفة حول قضايا عديدة ترتبط بتسيير مواكب العزاء في العشرة الأولى من شهر محرّم في الشوارع والطرقات، وخروج مواكب الزنجيل والتطبير. ومن العلماء من أصدر فتوى في جواز تسيير المواكب عادّين ذلك تبليغاً للدعوة الحسينيّة. واشترط عدد من علماء الشيعة لجواز تسيير المواكب، تنزيهها عمّا لا يليق بها مثل الغناء واستعمال آلات اللهو والتدافع في التقدّم والتأخّر بين أهل المحلّتين.
كما أنّ علماء الدين الشيعة اختلفوا حول التشبيهات والتمثيلات لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء، ولبس الرجال ملابس النساء وقد أصدر آية الله الميرزا محمّد حسين النائيني فتوى في جواز تسيير المواكب ردّاً على استفسار لأهالي البصرة. ووافق علماء كبار، منهم آية الله السيد محسن الحكيم، وآية الله العظمى محمود الحسينيّ الشاهروديّ، وآية الله الشيخ محمّد حسن المظفّر، وآية الله السيّد حسين حمامي، وآية الله السيّد عبد الهادي الشيرازيّ، وآية الله محمّد حسين آل كاشف الغطاء، وآية الله الشيخ محمّد كاظم الشيرازيّ، على فتوى آية الله النائينيّ في جواز خروج المواكب الحسينيّة ([152]).
أمّا اختلاف العلماء الشيعة فقد جاء حول جواز أو تحريم التطبير، فكان الجدال كبيراً بين العلماء حول حكم الشرع في التطبير. فمن العلماء من حلَّل التطبير الذي لا يُلحق الضرر بالإنسان أو يؤدّي إلى وفاته، واللطم على الصدر، والضرب بالزنجير على الظهر، عادّين ذلك من ضمن تعظيم شعائر الله. ويستشهد هؤلاء بالرواية المعروفة وغير المؤكَّدة بأنَّ زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب، وأخت الإمام الحسين ضربت رأسها بخشبة المحمل، وشجّت رأسها، وسالت الدماء منها حزناً على مقتل الحسين. ومنهم من حرَّمه على أساس أنَّ ذلك يُلحق الضرر بالانسان، ويشوّه سمعة المسلمين الشيعة أمام العالَم، ويصوّرهم كأناس لا يقيمون للدين وزناً، ويدخلون البِدع إلى الدين، ويثيرون الأعداء ضدّهم.
وقد أصدر أحد علماء الدين في العراق وهو آية الله السيد حسن الشيرازيّ الذي اغتيل في لبنان على يد حزب البعث العراقيّ كتاباً في السبعينات من القرن الماضي دافع فيه عن الشعائر الحسينيّة، ومنها خروج مواكب العزاء والتطبير حيث عدّ البكاء والتباكي وإقامة المآتم ولبس السواد وشقّ الجيوب واللطم وضرب السلاسل والتمثيل والتطبير في شهر محرّم من الشعائر الحسينيّة وتعظیم شعائر الله([153]).
تُقام مجالس العزاء أو (القراية) كما تُسمّى في العراق، لإحياء ذكرى استشهاد الحسين بن علي×، ويشارك في المجالس عدد كبير من الأفراد والجماعات، وتُقام في ساحة مسجد أو في حسينيّة، أو قاعة عامّة أو في أحد بيوت الوجهاء والأغنياء من الناس (أو حتى في بيوت الناس العاديّين تقرّباً إلى الله تعالى وحبّاً بالحسين بن علي×) حيث تُقام، في الأغلب، لمدّة عشرة أيام متتالية. وفي مثل هذه المجالس يقوم خطيب أو (قارئ) بقراءة قصّة من قصص واقعة الطفّ بكربلاء. «ومن المعتاد أن يقرأ الخطيب في كلّ يوم من الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم قصّة معينة تتحدَّث عن مأساة تخصّ الشهداء وبطولاتهم في معركة الطف بكربلاء، حيث يكون اليوم الأوّل مخصًصاً لاستشهاد أنصار الحسين، ولا سيّما الحرّ الرياحي وحبيب بن مظاهر، وغيرهما، حتى اليوم الخامس الذي يُخصَّص لقصّة استشهاد مسلم بن عقيل، في حين يُخصّص اليوم السادس لقصّة استشهاد عليّ الأكبر، واليوم السابع لقصّة استشهاد القاسم بن الحسن، والثامن لقصّة العبّاس بن علي، والتاسع لقصّة مقتل الإمام الحسين وطفله الرضيع. أمّا اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء، فيخصّص لقراءة مقتل الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه، وحرق خيام أهل البيت، وسبي النساء والأطفال([154])أمّا موضوع مجالس العزاء فهو متنوّع بالمعلومات التاريخيّة، التي تعتمد بصورة خاصّة على كتب المقاتل([155])والسير والتاريخ والحديث والسنّة...»([156]).
یشعر محبّو أهل البیت أنّ خلفاء بني أمیّة قتلوا الحسين؛ ليقضوا على حركته الثوريّة التي لو استمرّت لهددّت حكومتهم وكيانهم، ولنغّصت عليهم حياتهم المترَفَة القائمة على التوريث لا الكفاءة والجدارة، وقد ذكر التاريخ كيف أنّ الشيعة كانوا في مختلف العصور يخضعون لحكّام ظلمة يُنزلون بهم العذاب، ويقمعونهم أشدّ القمع، لا لسبب سوى أنّهم لا يرضون بالحكومات الجائرة، ويطالبون بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم المشروعة. وقد طبع الخوف والقمع والاضطهاد تاريخَ العراق بالحزن ولوّنه بالأسى، لذلك لم يجد الشيعيّ إلّا مراسم العزاء الحسينيّ وسيلةً من وسائل الرفض والمقاومة الخفيّة، وجسراً للتعبير عن الذات والدفاع عنها وحمايتها([157]).
شعر العراقيّون طوال عشرات السنين بالظلم نتيجة تولّي حكّام فرضوا عليهم التمييز والطائفيّة، وسلبوهم حقوقهم وأبعدوهم من مراكز القرار والجيش. في الوقت الذي يشكّل الشيعة العراقيّون الأكثريّة العدديّة إلّا أنّهم كانوا محرومين من حقوقهم. استغل شيعة العراق المناسبات الوطنيّة والدينيّة والشعبيّة والاحتفالات بذكرى استشهاد الحسين، لعرض حالة التذمّر والغضب الخفيّة، حين تكون هناك فسحة من الحريّة، ينفذ منها الخطباء والشعراء؛ لنقد النظام القائم والأوضاع الاجتماعيّة السيّئة. وغالباً ما يتمّ نقد النظام من خلال مقارنة استبداد رموزه باستبداد معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد.
وتقام مجالس تعزية النساء في كلٍّ من العراق وإيران ولبنان والبحرين والمنطقة الشرقيّة في السعودية، وهي مجالس العزاء الخاصّة بالنساء وتقام في شهر محرّم، وتقام القراية أو قراية النسوان في البيوت في (العراق) وتستمرّ قرابة عشرة أيام، حيث تجتمع النساء وهنَّ ملبّدات بالسواد ومسرحات الشعور، مكوّنات دائرة أو عدَّة دوائر وتتصدّرهن (الملاية) أو (العدّادة) و(القوالة) وهي التي تقرأ التعزية وتنشد المراثي الحسينيّة التي تصوّر مأساة كربلاء، وما حلّ بأهل البيت من ظلم وجور وسبي وتشريد، وتطعّم حديثها بقصائد شعريّة شعبيّة ترثي بها الإمام الحسين بألحان شجيّة([158]).
وتُقام مجالس تعزية النساء في البيوت والحسينيّات والمساجد، حيث تشارك النسوة فيها. ويقوم القارئ أو الخطيب بقراءة واقعة كربلاء ومقتل الحسين، أو تقوم ملاية بقراءة أشعار في رثاء الحسين وأهل بيته، كما تُقرأ في هذه المجالس سور من القرآن الكريم والأدعية المنقولة عن أئمة أهل البيت. وتُقدَّم في هذه المجالس الحلويات والفواكه والطعام.
بنى الشيعة الحسينيّات لإحياء مآتمهم على الإمام الحسين بعد أن كانت تقام في البيوت، واستُخدِمت الحسينيّات على مرّ التاريخ لعرض حادثة مقتل الإمام الحسين بن علي على الناس يقدّمها الخطيب الذي غالباً ما يجلس على المنبر متوسّطاً الناس، ليُبكيهم، ثمّ تبدأ شعائر أخرى كاللطم يليها توزيع الطعام.
فالحسينيّة هي المكان الذي يُقام فيه مجلس العزاء على الحسين بن عليّ. وقد بدأ الشيعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ببناء (الحسينيّات) كمؤسّسات دينيّة ـ ثقافية في العراق على غرار تكايا الصوفيّة، لإقامة الشعائر والطقوس الدينيّة ولا سيّما العزاء الحسينيّ، ولذلك اتخذت اسم الحسين شعاراً لها، وسُمّيت بـ(الحسينيّة).
يرى الباحث إبراهيم الحيدري أنّ أولى الحسينيّات التي شُيِّدت في العراق هي (الحسينيّة الحيدريّة) في مدينة الكاظميّة بالقرب من بغداد في العام 1297هـ/1876م. وتبعتها حسينيّة أخرى في بغداد، ثمّ ثالثة في الكاظميّة أيضاً. وفي كربلاء، تمّ بناء الحسينيّات في أوائل القرن العشرين، حيث شُيِّدت أوَّل حسينيّة لنزول زوار الإمام الحسين من الإيرانيّين، وكذلك لإقامة العزاء الحسينيّ في العام 1344هـ/1906م. حيث شُيّدت الحسينيّة الطهرانيّة. كما شُيّدت الحسينيّة الإصفهانيّة، وكانت حسينيّة الشوشتريّة في النجف أوّل حسينية شُيِّدت في العام 1319هـ/1884م. وفيها أقدم مكتبة من مكتبات العصر الحديث في النجف([159]).
تطوّرت الحسينيّات بالتدريج وتحوّلت إلى مؤسّسات اجتماعيّة ـ ثقافيّة، ولم تعد مكاناً لإقامة مراسم العزاء الحسينيّ فحسب، بل مدارس دينيّة، ومنتديات اجتماعيّة وثقافيّة. وعلى هذا المنوال، سار أهالي جبل عامل والبقاع في لبنان([160]).
الشَّبيه أو تمثيل مأساة الإمام الحسين× في العراق
يجري تمثيل واقعة عاشوراء في العشرة الأولى من شهر محرم من كلّ عام في المدن العراقيّة ولا سيّما كربلاء والنجف والكاظميّة وبغداد، ولا زال العراقيّون يواصلون الشبيه وتمثيل المعارك التي جرت في كربلاء. ولكن هذا التمثيل والشَّبيه لم يُنقل إلى المسرح حيث يقوم الممثِّلون بأداء دور الإمام الحسين× ويزيد.
وخلال شهر محرَّم يخرج الشَّبيه مع مواكب الزنجيل واللطم، حيث تجري معارك بين أصحاب الحسين× وجيش يزيد بن معاوية. وأولو المواكب يخرجون ومعهم الشَّبيه في الليالي الأولي من شهر محرَّم.
تبدأ التشابيه بقافلة الحسين× وعائلته للتعبير عن مسيرة الحسين من المدينة إلى كربلاء. «وينقسم الممثِّلون إلى مجموعتين، جيش الحسين قرب خيامهم التي تميّزها الرايات الخضراء والسوداء، وفي الجانب الآخر جيش يزيد براياتهم الحمراء ورايات أخرى مختلفة، وتبدأ المبارزات الفردية على الخيول الحقيقية، و الخطب الحماسية بين الممثِّلين فيؤكِّد كلُّ واحد منهم على عدالة القضية التي يدافع عنها والتي سيموت من أجلها، ويبدأ الحوار بين أحد الممثِّلين وممثِّل من الفريق الآخر، وكلٌّ منهم يذكر صفات الشخصية التي يمثِّلها ويعدِّد فضائلها التاريخية. وكثيراً ماتنقطع هذه الحوارات بمقاطع شعرية من الممثِّل (الرجل) الذي يمثِّل دور السيدة زينب (أخت الحسين)، والتي تؤدِّي دور رئيسة كورس النساء (عائلة الحسين) في ذات الوقت. وهذا الممثِّل يدور على الجمهور بصوته الشَّجي من أجل تحفيزه ودفعه للمشاركة الوجدانية. ودائماً يُكمِل الحدثَ أو أداء الممثِّل الرئيسي نعيٌ، وهذه ميزة مهمَّة في التعازي...» ([161]).
كما تُقام مراسم (عرس القاسم) منذ عشرات السنين في العراق، ولا سيما في كربلاء ليلة العاشر من محرّم، حيث يحمل أطفالٌ ويافعون شموعاً بيضاء مضاءة يسيرون في صفوف متوازية يردِّدون أبياتا من الشعر، في موكب كبير، وترمز إلى زفاف القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ليلة العاشر من محرّم.
كما يحمل رجال أقوياء غرفة مُثمَّنة الشكل مُزدانَة بالأقمشة والأضواء والشموع وتمثِّل غرفة زفاف القاسم بن الحسن.
منذ القِدَم، يقيم العراقيّون مراسم إحياء ذكرى الطفل الرضيع ابن الإمام الحسين× الذي قُتل في كربلاء، عندما رفعه أبوه ليطلب له شربة من الماء، وقد أصابه سهمٌ أنهى حياته، وبهذه المناسبة يصنع العراقيّون مهداً يغطّونه بالقماش الأبيض والأخضر، ويرفعونه على الأيدي خلال مراسم العزاء والمواكب التي تخرج بالمناسبة، ويضعون في المهد أطفالاً رُضَّعاً؛ تشبُّهاً بالطفل الرضيع علي الأصغر، وطلباً للسلامة لأطفالهم.
تنقل الروايات الواردة في كتب المقاتل أنّ الحسين بن علي عندما سقط عن ظهر فرسه ذي الجناح يوم عاشوراء، قام هذا الفرس بالدوران حول جسد الحسين، وقد خضّب ناصيته بدم الحسين، وتوجّه نحو خيام أهل بيته؛ ليخبرهم باستشهاده. وتنقل كتب المقاتل روايات عديدة عن فرس الحسين.
ويقول العلّامة محمّد باقر المجلسي في بحار الأنوار: «وأقبل فرس الحسين× وقد عدا من بين أيديهم أن لا يُؤخَذ، فوضع ناصيته في دم الحسين× ثمّ أقبل يركض نحو خيمة النساء، وهو يصهل ويضرب برأسه الأرض عند الخيمة حتى مات، فلمّا نظرت أخوات الحسين وبناته وأهله إلى الفرس ليس عليه أحد، رفعنَ أصواتهنّ بالبكاء والعويل، ووضعت أمّ كلثوم يدها على أمّ رأسها ونادت: وامحمّداه، واجدّاه، وانبيّاه، واأبا القاسماه، واعليّاه، واجعفراه، واحمزتاه، واحسناه، هذا حسين بالعراء، صريع كربلاء، مجزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، ثم غُشِي عليها»([162]). وجاء في زيارة الناحية المقدّسة المنسوبة إلى الإمام الحجّة بن الحسن العسكريّ (الإمام الثاني عشر عند الشيعة): «ولما نظرت النساء إلى الجواد مخزيّاً والسرج عليه ملويّاً، خرجن من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات»([163]).
وتخرج المواكب يوم عاشوراء ومعها فرس الحسين×، وقد وضعوا عليه قماشاً أبيض مصبوغاً بلون أحمر يرمز إلي مقتل الحسين، كما تُوضَع على القماش الأبيض نبال ترمز إلى توجيه النبال إلى الإمام الحسين، والذي أدَّي إلى استشهاده.
وتخرج في الأيام العشرة الأولي من شهر محرّم مواكب تمثِّل أهل البيت ضمن مواكب العزاء التي تخرج في العراق. ويضمّ موكب أشباه أسرى أهل بيت الحسين عدداً من الجمال التي تُزيَّن بأقمشة خضراء وسوداء، وهوادج عليها عدد من الأطفال والنساء يرمزون إلى أسرى أهل بيت الحسين الذين أُسِروا بعد استشهاده في كربلاء، ونُقلوا إلى الكوفة، ومنها إلى الشام والمدينة. كما يُوضَع رجلٌ على جمل مصفَّد بالحديد والأغلال ويُرمَز إلى علي بن الحسين زين العابدين× الذي كان مريضاً يوم عاشوراء، ولم يتمكّن من خوض المعركة وأُسِر مع النساء والأطفال.
وفي ليالي شهر محرَّم تحمل المواكب مشاعل، يحملها شبّان أقوياء وتدلّ على عظمة كلّ موكب عزاء، ومدى جاهزيته في إقامة العزاء الحسينيّ وإحياء ذكرى الإمام الحسين×.
وحملُ التوابيتِ خلال مواكب العزاء یرمز إلى استشهاد أصحاب الحسين وأهل بيته في كربلاء، وهذه العادة تُمارَس في العديد من البلدان، وخاصة في إيران و الهند والعديد من البلدان الآسيويّة وتطلق عليها أسماء مختلفة.
مسلم بن عقيل هو ابن عم الحسين بن عليّ، أرسله مبعوثاً عنه إلى الكوفة ليستطلع أحوال أهل الكوفة ويخبره بأمرهم، وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة واستقبله الكوفيّون ولكنّهم تخلّوا عنه بفعل ضغوط والي الكوفة عبيد الله بن زياد، وأخيراً أخذ مُسلم أسيراً وقُتل. وفي المراسم التي تقام في الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم تُقام طقوس شَبيه مسلم بن عقيل، حيث يلبس شبيه مسلم لباساً أخضر اللون، ويضع خُوذة على رأسه ويأخذ ترساً بيده.
كما تُقام طقوس أسر (أولاد مسلم بن عقيل)، في هذه الطقوس يأخذ رجل يمثّل الجلّاد المسمّى الحارث، بطرف حبل رُبطَ في طرفه الآخر طفلان يمثّلان ولدَي مسلم بن عقيل، وهما إبراهيم ومحمّد، المدفونان بالقرب من مدينة المسيَّب شمال كربلاء، ويرتدي كلّ من هذين الطفلين ثوباً أخضرَ اللون ويغطّي قماش أسود رأسيهما، وهما حافيا القدمين، ويسير الحارث بالطفلين ليأخذهما إلى والي الكوفة عبيد الله بن زياد، وبيده عصا يضرب بها الطفلين بين الحين والآخر.
من ضمن العُروض التي كانت رائجة في العراق فی الستینات من القرن الماضی، (عرض شبيه الأسد)، يمثّله رجل يرتدي جلد أسد، ويجلس على محفّة خشبية يحملها الرجال على عواتقهم ويسيرون بها في موكب العزاء. ويرمز شبيه الأسد إلى حزن الحيوان على مقتل الحسين، ويقوم شبيه الأسد بنثر التبن على رؤوس المعزّين في إشارة إلى الحزن على استشهاد الحسين. كما أنّه کان يرفع يداً من الجلد ترمز إلى يد العبّاس بن علي التي قُطِعت في معركة كربلاء. وكانت هذه العروض تقام في كربلاء حيث شاهدها الباحث هناك.
وهناك روايات تحدَّثت عن ظهور أسد في كربلاء بعد يوم العاشر من محرَّم. الرواية الأولى منقولة من كتاب (مشارق أنوار اليقين في أنوار أمير المؤمنين) للحافظ رجب البرسي ونصُّ الرواية أنَّ فضة رضوان الله تعالى عليها ـ وهي خادمة السيدة فاطمة الزهراء÷ ـ قد تعلَّمت دعاءً عن الإمام أمير المؤمنين علي×، ودعت بهذا الدعاء في ليلة الحادي عشر من محرَّم، فجاء أسد لحماية الأجساد الطاهرة لحين وصول الإمام السجاد×، ودفن أجساد الشهداء.
الرواية الثانية منقولة في كتاب (بحار الانوار) الجزء 45، وتقول: «عندما بقيت جُثَث الحسين وأهل بيته وأصحابه في كربلاء بعد رحيل الجيوش يحكي رجلٌ أسدي حادثة قدوم أسد إلى منطقة الشهداء، فانتظر هذا الشخص ليتأكَّد إن كان الأسد سيأكل الجثث، فتخطَّى القتلى حتى وقف على جسد كأنَّه الشمس إذا طلعت فبرك عليه، فقلت: يأكل منه وإذا به يمرِّغ وجهه عليه، وهو يهمهم ويدمدم»([164]).
اعتاد أهالي كربلاء في الستينات من القرن الماضي إقامة الخيام داخل الصحن الحسینی کلَّ عام فی شهر محرَّم، وکانت مجالس العزاء تُقام تحت هذه الخیم.کما کانت تُنصَب خیم بالقرب من المخيَّم الحسيني الذي يبعد 200 مترا إلى الطرف الجنوبي الغربي من الحائر الحسيني؛ لغرض حرقها بمشهد مشابه لأحداث يوم عاشوراء.
ويقول مسؤول حرق الخيام الحاج رزاق عبد الكريم الميالي حول طقس حرق الخيام في كربلاء: «توارثنا إقامة هذه الشعيرة من آبائنا وأجدادنا، إلا أنَّها فُعِلت بشكل أكبر بعد سقوط النظام البائد عام 2003م، حيث بدأنا بإعادتها بشكل أكثر تنظيماً من خلال خياطة الخيم وتحضيرها قُبيل العاشر من محرَّم بفترة وجيزة؛ لتُنصَب بعد ذلك قرب المخيم الحسيني الحالي، إذ تُنصَب في البداية خيمة الإمام الحسين الكبيرة وبجوارها خيمة العباس وخيمة القاسم وخيمة السيدة زينب^، لتأتي بعد ذلك وبعد صلاة الظهر مباشرة فِرَق التشابيه التي تمثِّل معسكر يزيد ممن يرتدون أزياء جيش عمر بن سعد من الخيّالة والراجلة حاملين معهم مشاعل نارية؛ ليرموها وسط الخيام بمشهد تراجيدي يستحضر فيه المتلقي حادثة حرق خيام أبي عبد الله الحسين× وعياله بما يصوِّر جرأة اعداء الله على البيت النبوي الكريم دونما خوف أو تردد».
كما بيّن الميالي: «أنَّ الهدف من إقامة هذه المراسيم هو إيصال رسالة حسية مصوّرة إلى العالَم أجمع عن حجم مصيبة الإمام الحسين× وفعلة أعداء الإسلام بأهل بيت الرسول محمد|، فضلاً عما تتضمنه من مضامين سامية لا أقلَّها الحفاظ على ديمومة واستمرارية هذه الشعيرة وإحيائها دائماً وأبداً، واستلهام قيمها الحقَّة التي جسّدها البيت النبوي الكريم»([165]).
تروي كتب التاريخ أنَّ أجساد الإمام الحسين وشهداء كربلاء بقيت ثلاثة أيام مرمية على أرض كربلاء دون أن يقوم أحد بدفنها، ولكنَّ بني أسد الذين كانوا يسكنون قرب أرض كربلاء جاؤوا في اليوم الثالث عشر من محرَّم إلى ساحة المعركة، ووجدوا الأجساد مرمية على الأرض ولم يتعرَّفوا على أجساد الشهداء، لانَّها كانت مقطوعة الرؤوس. وقد جاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين×، وقام بدفن جسد الإمام الحسين وأخيه العباس، وساعدته عشيره بين أسد على دفن بقية الشهداء.
ويُعتبَر موكب بني أسد من أقدم مواكب العزاء التي إعتادت على إحياء ذكرى دفن الأجساد الطاهرة لشهداء كربلاء منذ سنة 61 للهجرة.ويخرج الموكب كلَّ عام يتقدَّمه نعش رمزي يمثِّل نعش سيد الشهداء× تتبعه جموع المعزِّين بالإضافة إلى التشابيه الأخرى التي جسَّدت شخصية الإمام علي بن الحسين السجاد× يرافقه أبناء قبيلة بني أسد الذين يحملون بعض الأدوات الخاصة بمراسيم الدفن (كالمجارف والفؤوس والزبلان)؛ وذلك لإثارة المشاعر. وتشارك نساء بني أسد في هذا اليوم تيمُّناً بالذكرى التاريخية لهذا اليوم الذي يتحدَّث عن قيام نساء قبيلة بني أسد في سنة 61 هجرية بالاتجاه نحو شهداء واقعة الطف؛ لدفن الجثث الطاهرة مع رجال القبيلة، وعندما علمن بأنَّ الشهداء هم الإمام الحسين× وأخوه العباس×، وآل بيته أكثرنَ من الصراخ والعويل لفعل يزيد ومعاوية ([166]).
كاتب عربي يتحدّث عن التشابيه والتمثيل في العراق
«لقد قام العراقيّون خلال القرن الماضي بتمثيل فاجعة كربلاء في العاصمة العراقيّة بغداد والمدن المقدّسة في كربلاء والنجف والكاظميّة، فكان التمثيل يجري بصورة حيّة فتُنصَب الخيام في الساحات، ولا سيّما الساحات المحيطة بأضرحة الحسين والعبّاس في كربلاء، أو في صحن الكاظميّة، وجامع الخلَّاني في بغداد، فيرتدي الأمويّون الملابس الحمراء، بينما يرتدي الحسين وأصحابه الملابس الخضراء، ويحمل الطرفان الرماح والسيوف والدروع والأقواس والسهام، وتشخّص المعارك والمبارزات ولا سيّما بين الشخصيّات الرئيسيّة»([167]).
«ولا يقتصر المشهد على الحركات التشخيصيّة الصامتة كالهجوم والدفاع وإظهار شجاعة الحسين ورجاله وجَلَدِهم، وآلآم النساء والأطفال، من جهة، وقساوة الأمويّين ورجالهم من جهة أخرى، بل كان يجري بالإضافة إلى ذلك حوار وكلام بين الشخصيّات الرئيسيّة المذكورة... وكانت المواكب تسير وضمنها جثث القتلى تُصنع من قماش ويحشى بالتبن»([168]).
جرت محاولات عدیدة من أجل إرساء أسس مسرح التعزية في العراق، ولكنَّ الظروف السياسية حالت دون ذلك، خاصة وأنَّ النظام السابق لم يكن يسمح بأيَّة خطوة في سبيل ارساء أسس مسرح التعزية.
«وبحلول العام 1979م عندما تسلّم صدام الحكم رسميا شهد الكثير من الحوادث التراجيدية كانهيار الجبهة الوطنية والثقافية من العراق؛ مخافة بطش النظام الحاكم الذي قتل واحداً من أهمِّ علماء الشيعة، وهو الشهيد محمد باقر الصدر»([169]).
وقام النظام بحظر طقوس التعزية، حيث شمل حتى المراسيم البسيطة والروتينية لاحياء المناسبة، كقراءة الاناشيد الدينية والمشاركة في العزاءات الرجالية والنسائية، والاستماع إلى الخطب والمواعظ والحكم واللطميات.هكذا غُيِّب الدور الحضاري العراقي الحقيقي وبضمنه الحديث عن طقس مسرحي متوارث منذ مئات السنين، وهو طقس التعازي([170]).
لقد كان على المسرحيين العراقيين أن يكونوا حذرين جدّاً في تصدِّيهم لإثارة هذا النوع، إثارة حتى لو كانت بسيطة وهامشية في متن العرض وكلياته، إلا أنَّ مفعولها السلبي قد يزهق أرواح من يقومون بها.. محاولات كثيرة جرت من هذا النوع كانت تمثِّل البذور، ولعلَّ مسرحية الفنان كريم رشيد (الحرّ الرياحي) التي قُدِّمت من على خشبة المسرح الوطني بكادر من طلبة كلية الفنون بجامعة بابل أوائل عقد التسعينات الماضي تمثِّل أبرز عرض مسرحي متكامل يتناول بصورة مباشرة بعض جزئيات واقعة عاشوراء.ومسرحية (الحرّ الرياحي) كتبها الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد قبل الحرب مع إيران بسنوات، ولكنَّها ظلَّت على رفوف المكتبات، وبالرغم من صلة كاتبها الوثيقة برأس النظام إلا أنَّ المشاريع التي قُدِّمت للجهات المسؤولة من أجل إنتاجها ظلَّت تُواجَه بالرفض دائما. وكان الفنان عزيز خيون واحداً من أبرز المخرجين العراقيين توقاً لتقديم هذا النصِّ، ولم يفلح أبداً.. يتناول النصُّ سيرة واحد من رجال الواقعة، هو الحرُّ الرياحي، الذي أُوفِد لإيقاف زحف الحسين بن علي× إلى كربلاء، فشدَّه منظر الإمام وصلابته، فانقلب ضدَّ من أرسله وصار أحد فرسان الإمام، في ثنائية تقابلها شخصية الشمر بن ذي الجوشن قاتل الإمام الحسين×..استمرَّ العرض لمدة يوم واحد، ولم تثمر بعده محاولات لإعادة العرض، كان العرض بمثابة قنبلة كبيرة وسط ركام من المنع، المنع الذي يخصُّ بشكل استثنائي كلَّ ما له علاقة بمسرح التعزية، أو واقعة كربلاء...([171]).
لكن العام 1996 كان عام المحاولة الابرز لصياغة عرض مسرحي عراقي يتناول واقعة الطفِّ بتفاصيلها، وقد بُوشِر بأخذ الموافقات الأصولية الرسمية لإنتاج هذا العرض الذي تبنَّت إنتاجه إحدى شركات الإعلان التجاري، ومن المؤكَّد أنَّها حسبت مقدار الفوائد المادية الكبرى التي سوف تحقِّقها إذا ما أُجيز العرض. في هذه الأثناء أكمل الكاتب العراقي علي حسين تأليف النصِّ مستنداً إلى عدد من النصوص المسرحية التي تناولت سيرة الإمام الحسين×، ومنها نصوص جلال الشرقاوي، ومحمد علي الخفاجي وغيرها، أما شركة الإنتاج فوجدت في طريقها مشاكل فنية كبيرة، ومن هذه المشاكل تسمية مخرج العرض، حيث اتفقت الآراء على تشكيل فريق عمل إخراجي بقيادة الفنَّان سامي عبد الحميد وعضوية الفنّانَين غانم حميد وكاظم النَّصار..ثمَّ كان على هؤلاء مجتمعين حَلُّ مشكلة التمثيل، فقد كانت الكثير من الآراء، وبضمنها بالطبع آراء رجال الدين، بضرورة عدم إظهار الشخصيات المقدَّسة على المسرح، أما مشكلة مكان العرض فكان ثَمَّة مقترحان: الأول يتمثَّل بالفضاء المفتوح واختِير له ما يُعرف بالمدرسة المستنصرية الواقعة على ضفاف دجلة في رصافة بغداد، والثاني هو المسرح المغلق، أو مسرح العلبة الإيطالي ووقع الاختيار على قاعة المسرح الوطني ببغداد … ولكنَّ الحماسة، والتجارة أيضاً لم تكن لتكفي في العراق الماضي، حيث تصدّى للمشروع الكثير من أعضاء القيادات الرسمية العليا بحجة أنَّ هذا المشروع من الممكن أن (يؤدي إلى إثارة النعرات الطائفية)، وهي حجة معروف سلفاً ماذا كانت تعني حينذاك … وهكذا أُلغِي المشروع([172]).
هناك رأي آخر للباحث العراقيّ الدكتور مناضل داود حول مسرح التعزية حيث يرى بأنّ العراقيّين لم يشهدوا مسرحاً على أرض الواقع، ولم يجروا بحثاً أو استقراءً أو تجربة واحدة([173]). وهو يعزو غياب هذا الاهتمام إلى ثلاثة أسباب، أوّلها: إنّ السلطة الرسميّة في العراق ومنذ أن تكوّنت الدولة هي سلطة طائفيّة أبعدت الشيعة من مراكز الحكم، وثانيها: إنّ عمر المسرح العراقيّ قصير، ولما بدأ مخرجوه الذين درسوا في روسيا وأوروبا وأميركا بالعمل في المسرح العراقيّ قدّموا تجارب جاهزة مستوحاة من ثقافة المكان الذي درسوا فيه، ومتأثّرة بالمدارس المسرحيّة الغربيّة. أما السبب الثالث فيكمن ـ بحسب داود ـ في أنّ أغلب المثقّفين العراقيّين كانوا وما زالوا يتفادون هذه الطقوس؛ وذلك نابع بحسب رأيه من أنّ معظم هؤلاء المثقّفين ينظرون إلى الإسلام بشكل فوقيّ متأثّرين بالفلسفات الأخرى، وهو يعدّ ذلك نظرة سطحيّة خالية من التأمّل، ودليله على ذلك هو: «أنّ الثقافة السائدة لدينا تناست الإشراقات العظيمة في الإسلام، والمتمثّلة في التصوّف، وإخوان الصفا، والمعتزلة، والقرامطة، على سبيل الأمثلة، مشيرا إلى التأثيرات العظيمة التي تركتها الثقافة الإسلاميّة على الغرب في عصور سابقة، الأمر الذي يؤكّد قوّة الثقافة الإسلاميّة وأهميّة الحضارة التي كوّنتها»([174]).
ويلاحظ الباحث أنّ هذه الطقوس تكاد تتجاوز المعنى الدينيّ الضيّق لتتحوّل إلى تعبير عن الرفض للواقع السياسيّ القائم، وهو ما يكسبها بُعداً درامياً جديداً يتجدّد مع كلّ مرحلة، إذ يقول في هذا السياق: «إنَّ إعادة تمثيل واقعة استشهاد الحسين بن علي كلّ عام في العراق، هي تعبير الناس عن الرغبة في محاكاة الواقعة التي تحاول الانسلاخ عن الدين في أحيان كثيرة، وذلك لمحاكاة الظروف المستجدّة على المستويات الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة على الوجه الأخصّ».
ويستند الدكتور داود إلى ما يراه الدكتور فاضل السودانيّ الذي يقول بدوره: «ومن المعروف أنّ التعازي في بداية نشوئها كانت تقليداً حيّاً لمأساة (الإمام الحسين) بكلّ تفاصيلها الواقعيّة، ولكن بمرور الزمن لم تعد طقساً دينياً فحسب، وإنّما امتزجت بالحياة السياسيّة والاجتماعيّة»([175]). ويستشهد الباحث، كذلك، سعياً لتأكيد هذا الرأي، بما يقوله فاضل الربيعيّ، الذي يتساءل: «ما الذي يدفع العراقيّين لإعادة هذه الواقعة بكلّ هذه القوة كلّ عام والمكتوبة بكثافة الشعر؟ سيُقال لنا حتماً إنّ العامل الدينيّ يقف وراء كلّ هذا. لكنّ هذا ليس كافياً، فالناس تبحث عن بطلها المفقود، بطلها الذي مات، ولا بدّ من إيجاد رمز لبطل قوميّ في زمن غاب فيه الأبطال، فكان الحسين هو المثل الأعلى لهم»، ويؤكّد الباحث أنّ التاريخ يكشف عن أنّ الطابع السياسيّ المعارض لسلطة الحاكم في طقوس التعزية ليس بجديد ولم يبدأ في القرن العشرين، بل كانت بدايته منذ أن تكوّنت فكرة التشيع.
يشرح الباحث طبيعة التعزية في الثقافة المعاصرة، ويتوقّف في هذا الفصل عند طقوس عاشوراء ومجالس التعزية، ويخصّ بالحديث المجالس الحسينيّة، والمواكب واللطم لدى الرجال والنساء الذي يُعدّ شعيرة رئيسة من شعائر هذه المناسبة الدينيّة، ويختم بحديث عن التعزية في تجربة المسرح الأوروبيّ المعاصر.
يقدّم الدكتور مناضل داود شهادات وأمثلة لباحثين ونقّاد برزوا في مجال مسرح التعزية، منهم بيتر بروك الذي يتحدّث عن مسرح التعزية في إيران ويقول: «شاهدت في قرية إيرانيّة نائية شيئاً من أقوى الأشياء التي شاهدتها في المسرح في أيّما وقت مضى»، وهو بهذا يشير إلى الطقس العاشورائيّ الذي أثّر في نفسه، مثلما أثّر في نفس الباحث مناضل داود الذي عاش وترعرع في ظلّ هذه الثقافة، وشاهد كيف أنّ هذه الطقوس كانت تُمارَس عندما كان طفلاً، ولم يكن يستوعب بمعايير طفولته الساذجة شيئاً ممّا يجري أمامه، وعندما كبر ودرس المسرح عاد إلى دراسة تلك الطقوس ونقّب في دلالاتها، ورموزها، وألغازها، وتفاصيلها الغامضة، وقدّم كتابه (مسرح التعزية في العراق) الذي يُعدّ إضافة مهمّة إلى المكتبة المسرحيّة العربيّة التي تفتقر إلى مثل هذا النوع من الدراسات، بحسب رأي إبراهيم حاج عبدي. ولعلّ ميزة هذا الكتاب الرئيسة تتمثّل في سعي الباحث إلى إماطة اللثام عن حدث تقليديّ سنويّ يتكرّر منذ عدّة قرون، غير أنّ أحداً لم يلتفت إليه ولم يناقشه([176]).
تقول المستشرقة السوفيتيّة تمارا الكساندروفنا في كتابها (ألف عام وعام على المسرح العربيّ)، وبعد اطلاعها على الأحداث الملازمة لقضية الحسين× ـ ما قبل وما بعد ـ بوصفها مادّة مشبعة بالدراما الحقيقية والتراجيديا، تقول: «ولا يتبقّى لنا في النتيجة إلّا أن نأسف لعدم ولادة شكسبير عربيّ، كان بإستطاعته تجسيد طباع أبطاله وسلوكهم في الشكل الفنيّ للتراجيديا الدمويّة. وتضيف: إنّ في هذه المادة من المؤامرات والقسوة والتعسّف والشرّ ما لا يقلّ عمّا كانت عليه في مواضيع عصر حروب الوردة الحمراء والوردة البيضاء، لكن على الرغم من عدم توفّر الأساس الأدبيّ المتين، فقد أدّى مصير الحسين المأساويّ وأدّت معركة كربلاء إلى ولادة (التعزية) التي تُعدّ من أقدم العروض المسرحيّة في العالم الإسلاميّ».
وللباحث العراقيّ لطيف حسن رأي مختلف؛ إذ إنَّه يرى «أنّ محاولات هزيلة وسطحيّة جرت في الحقبة الأخيرة في المسرح العراقيّ لاستلهام المقتل وطقوس التعازي وسيرة آل البيت، فشلت جميعها وأضرّت بقدسيّة المناسبة. ويرى الكاتب أنّ المشكلة لا تكمن في استلهام الطقس لفنِّ المسرح القائم أصلا، بل المشكلة هي في الإمكانيات المتوافرة داخل هذه الطقوس نفسها التي تمنحها قدرة أن ترتقي بالطقس كلّه وتتحوّل به من الشارع إلى المسرح، أي أن تترك مهرجان الشارع نهائيّاً بلا عودة، وتدخل المسرح الذي تشكّله على مقاسها» ([177]).
ونستنتج مما سبق أنّ مسرح التعزية الرسمی في العراق لم يتطوّر لأسباب عديدة منها منع النظام السابق لكلِّ المحاولات التي جرت من أجل إرساء دعائم هذا المسرح، كما أنَّ عدم وجود محاولات جادّة من المسرحيّين العراقيّين في مواصلة هذا النوع من المسرح الذي تطوّر ونما في إيران، وأصبح ملمحاً مهمَّاً في المسرح الإيرانيّ يحاول أن يصل إلى العالميّة.
العزاء الحسيني في البلدان العربية الأخرى
بدأت مراسم التعزية في لبنان في أواخر القرن التاسع عشر في مدينتي النبطيّة وبنت جبيل اللتين يسكنهما الشيعة. وكانت المنطقة قد تحوّلت منذ العام 1943م إلى محافظة لبنان الجنوبيّ، بعد أن كانت خاضعة للحكم العثمانيّ حتى العام 1918م. كانت تقام مراسم العزاء في المدينتين في الخفاء خوفاً من العثمانيّين. وكان العثمانيّون قد عاملوا الشيعة على أساس مذهبيّ، ومنعوا إقامة مراسم العزاء الحسينيّ في عاشوراء، وكانت دوريّات تدور في الشوارع والطرقات أيام عاشوراء؛ لمنع الاجتماعات وإقامة التظاهرات. وكان حاكم نابلس آنذاك قد أصدر أمراً بوضع حراسة دائمة على مدخل حسينيّة النبطيّة؛ منعاً لأيّ تجمعات أو إقامة أيّ احتفالات([178]).
ولجأ أهالي النبطيّة إلى إقامة مجالس العزاء في بيوت الأقرباء والأصدقاء داخل المدينة بعد وضعهم رقيباً على مدخل الشارع المؤدّي إلى المكان الذي يُقام فيه مجلس العزاء، فإذا جاءت الدوريّات العثمانيّة تحوّل مجلس العزاء تلقائيّاً إلى اجتماع للأصدقاء والأقارب لتناول الشاي. اقتصرت مجالس التعزية آنذاك على قراءة سيرة الإمام الحسين وأهل بيته وما جرى لهم من مآس في كربلاء([179]).
وتذكر بعض المصادر أنَّ مجالس التعزية في النبطيّة بدأت في القرن العشرين؛ إذ أقام تجار إيرانيّون كانوا في النبطيّة مجالس التعزية في البيوت([180]). وفي يوم عاشوراء من العام 1921م قامت مجموعة من الشباب اللبنانيّين بتمثيل واقعة الطف بكربلاء، في النبطيّة. وقد تُرجِم نصّ المسرحيّة من اللغة الفارسيّة إلى العربيّة في العام 1927 وبقي مستخدماً مع بعض التعديلات. وفي مطلع القرن العشرين كان عددٌ من التجار الإيرانيّين المقيمين في مدينة النبطيّة يحتفلون بذكرى عاشوراء على طريقتهم الخاصّة، حيث يقومون بأداء تمثيليّة تروي واقعة كربلاء ويؤدّيها شخصان باللغة الفارسيّة، واحد يمثّل الإمام الحسين وآخر يمثّل دور الشمر قاتل الحسين في إطار تمثيليّة بسيطة، وكانت تجري تلك التمثيليّة بإذن من الباب العالي([181]).
استمرّت إقامة عروض التعزية المسماة (مسرحيّة عاشوراء) على مسرح خشبي شعبيّ وبسيط في ساحة البيدر في النبطيّة، حتى العام 1971م، وكانت تحت إشراف النادي الحسينيّ في النبطيّة، أمّا بعد هذا التاريخ فقد أُقيمت على مسرح شعبيّ كبير نُصب أمام النادي الحسينيّ في النبطيّة. وقد شاهد الباحث في بداية السبعينات عروض التعزية التي كانت تقام على مسرح خشبيّ في النبطيّة، وكان يتبارز على المسرح من يمثّل الحسين بن علي وأصحابه الذين كانوا يلبسون الثياب الخضراء، بينما كان من يمثّلون جيش الأمويّين يلبسون الثياب الحمراء والصفراء والزرقاء. وكانت المعركة يوم عاشوراء تنتهي بقتل الحسين بن علي وأولاده وأصحابه وأسر أهل بيته. وفي ختام مسرحيّة عاشوراء كان العديد من الشباب يحملون المدى والسيوف يضربون رؤوسهم تأثّراً بمقتل الإمام الحسين وذبحه، ونصب رأسه وأصحابه على الرماح، وبعدها كانت تنتهي المراسم.
وفي بداية السبعينات من القرن الماضي كانت تقام في الكليّة العاملية في بيروت احتفالات كبيرة في ذكرى استشهاد الحسين، وتتواصل لمدّة عشرة أيام يلقي أحد الخطباء خطبةً حماسيّة حول استشهاد الحسين، يعقبه أحد النائحين فيقرأ شعراً في رثاء الحسين. وكان السيد موسى الصدر رئيس المجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى آنذاك يحضر الاحتفال ويلقى كلمة في الحاضرين يتحدّث فيها عن فلسفة استشهاد الحسين. وكان السيد موسى الصدر قد أنشا حركة المحرومين في السبعينات من القرن الماضي لمواجهة اعتداءات إسرائيل.
في بداية الثمانينات من القرن الماضي بدأت مسيرات كبيرة بالخروج في العاصمة اللبنانية بيروت في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، ولا زالت هذه المسيرات تخرج في هذا اليوم من كلّ عام، ويشارك فيها الآلاف من أبناء الطائفة الشيعيّة، وتجوب الضاحية الجنوبيّة من بيروت، حيث يلبس المشاركون رجالاً ونساءا وأطفالاً لباس الحداد، ويلطمون صدروهم ويردّدون الشعارات الدينيّة([182]).
في القاهرة ـ حيث يوجد مسجد سيّدنا الحسين في حي الحسين في العاصمة المصريّة ([183])، تُقام سنويّاً احتفالات يوم عاشوراء، ولا سيّما في المسجد الذي يقع بجانب جامع الأزهر، ويتوسّط المسجد ضريح يطلق عليه المصريّون (قُبَّة الإمام الحسين)، وهو مزار كبير يؤمّه آلاف المسلمين للتبرّك وبثّ الشكوى والتقرّب إلى الله. ويعود الاهتمام بهذه القُبَّة إلى الاعتقاد بأنّ هذا الضريح يضمّ رأس الحسين كما يعتقد آخرون بأنّه يضمُّ جسده([184]).كان الفاطميّون (909 ـ 1171م) قد أخذوا من ذلك الحين يقرأون المراثي ويقيمون المناحات، وخلال حكم الوزير الفضل بدر الدين انتشر العزاء في مصر، وكان بدر الدين يحضر بنفسه مراسيم الندب على الحسين يوم عاشوراء في مسجد القاهرة. وكان العلماء والفقهاء والوزراء يجلسون عن يمينه والمبشّرون عن يساره، ويقوم أحد الخطباء بتلاوة مرثيّة حزينة في تمجيد ذكرى الإمام الحسين([185]).
ونقل المقريزيّ في خططه «أنّ شعائر الحزن على الحسين يوم العاشر من محرّم كانت تُقام أيام الإخشيديّين، واتسع نطاقها أيام الفاطميّين الذين جعلوا يوم عاشوراء يوم حداد رسميّ، تتعطّل فيه الأسواق ويُقام فيه سماط الحزن الذي يُنظَّم بمنتهى البساطة، في بهو بسيط، ويجهّز بأصناف الطعام الخشنة مثل خبز الشعير والعدس الأسود والجبن، ويحضره الخليفة الفاطميّ، وهو ملثّم وفي ثياب قاتمة. كما كان الأمراء ورجال الدولة يشاركون الخليفة في السماط، وهم ملثّمون حفاة الأرجل تعبيراً عن الحزن العميق. ومن ذلك الحين أخذ المصريّون يحتفلون بذكرى استشهاد الحسين، ولا سيّما يوم عاشوراء في كلّ عام»([186]).
ويقول المقريزي ايضاً: «انصرف خلق من الشيعة في يوم عاشوراء من سنة ثلاث وستين وثلثمائة إلى المشهدين قبر كلثوم ونفيسة ومعهم جماعة من فرسان المغاربة ورجالتهم بالنياحة والبكاء على الحسين×»([187]).
ولم يكتفِ الفاطميون بإقامة العزاء في مراقد اهل البيت^، بل قاموا ببناء أماكن خاصَّة لذلك سمَّوها بالحسينية، وفي ذلك يقول المقريزي: «وكان من أهمِّ عمارة القاهرة في عهد الفاطميّين الحسينيّة، وهي بناء فسيح الأرجاء تُقام فيه ذكرى مقتل الحسين في موقعة كربلاء، وأمعن الفاطميّون في إحياء هذه الشعائر وما إليها من شعائر الشيعة حتى أصبحت جزءاً من حياة الناس»([188]).
يقوم زوّار مقام الإمام الحسين بقراءة الفاتحة على روح الإمام الحسين، ثمّ يصلّون ويطلبون البركة والشفاعة. ويعُدّ الحسين أعظم الأولياء المقدّسين في مصر، يحتفلون بيوم ولادته ويوم استشهاده. وقد جرت العادة أن يحتفل المصريّون بمولده يوم الثلاثاء، بعد مرور أربعة عشر يوماً على مولده الحقيقيّ. ويعتقد البعض بأنّ تفسير ذلك يعود إلى الإعتقاد بأنّ النبي الكريم يشارك بنفسه في هذا الاحتفال ويشهد للحاضرين الذين يحتفلون بمولد حفيده شخصيّاً يوم القيامة. ويعتقد الكثيرون من المصريّين بأنّ مصر (محروسة) بأهل بيت النبي، وذلك بسبب وجود قُبَّة الإمام الحسين بالقاهرة، وكذلك وجود حرم (مرقد) السيدة زينب، وقبر الإمام زين العابدين، والسيدة نفيسة بنت الإمام الحسن بن زيد بن الحسن بن علي([189]).
وبسبب ظهور الحركات السلفيّة في مصر، ولا سيّما في السنوات الأخيرة واتِّهام الشيعة المصريّين بنشر المذهب الشيعيّ في مصر، أصدرت الحكومة المصرية في العام 2015 أمراً بإغلاق مرقد السيدة زينب في القاهرة، وبعض المساجد التي يرتادها الشيعة في يوم عاشوراء.
يقيم الشيعة في دول الخليج ـ ولا سيما البحرين والسعوديّة وسلطنة عمان والكويت والإمارات العربيّة المتحدة وقطر ـ مراسم العزاء في شهر محرّم من كلّ عام في الحسينيّات التي شيّدوها في القرون الماضية على الرغم من محاولات الحكومات في بعض تلك الدول المنع أو التضييق على الشيعة.
تُقام مجالس العزاء في الحسينيّات والمساجد والبيوت في البحرين، وقد واجهت في السنوات الأخيرة محاولات من الحكومة؛ لمنع مجالس العزاء، أو خروج المواكب بسبب التوتّر الحاصل بين الحكومة والشيعة، الذين يشكّلون أغلبيّة السكّان. وتوجد في البحرين حوالى ثلاثة آلاف وخمسمائة حسينيّة. ويأتي الكثير من الموالين من دول الخليج المجاورة لأداء الشعائر الحسينيّة في البحرين([190]).
يعيش الشيعة السعوديّون في المنطقة الشرقيّة (الأحساء والقطيف) والمدينة المنوّرة وجدّة ومكّة وحائل ونجران، وينشطون في إقامة مراسم العزاء وخروج مواكب العزاء في شهر محرّم، وتقام مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الحسين في الحسينيّات الكثيرة المنتشرة في المنطقة الشرقيّة.
في شهر محرّم لعام 1426هـ/ شباط ـ فبراير 2005م حظرت السلطات السعوديّة إقامة عمل مسرحيّ دينيّ خاصّ بموسم عاشوراء، وفي شهر صفر (آذار/مارس) من العام نفسه منعت السلطات مهرجاناً دينيّاً بمناسبة ذكرى أربعينيّة الإمام الحسين، كما منعت معرضاً تشكيليّاً للمناسبة نفسها في الأحساء([191]).
في الكويت ينشط الشيعة الكويتيّون الذين يشكّلون 30 بالمائة من سكّانها، في إقامة مراسم العزاء في شهر محرّم في الحسينيّات الكثيرة المنتشرة في مختلف مناطق الكويت. وتوجد حوالى 800 حسينيّة في الكويت تُقام فيها مراسم العزاء في عاشوراء([192]).
في الإمارات العربيّة المتحدة تبلغ نسبة الشيعة 15 بالمائة، أو 25 بالمائة بحسب بعض المصادر من إجمالي عدد سكّان دولة الإمارات الذي يبلغ نحو 4، 5 مليون. تتمتّع الأقلّية الشيعيّة بالحريّة في ممارسة شعائرها الدينيّة بحسب تقرير وزارة الخارجيّة الإمريكيّة، وتُعدّ جوامع الشيعة وحسينيّاتهم ومآتمهم كافّة ملكاً خاصاً، ولا تتلقّى أيَّ تمويل من الحكومة. وللشيعة أربعة مساجد في (أبو ظبي) وأربعة مآتم تُقام فيها مراسم العزاء. في السنوات الأخيرة يتعرّض الشيعة في الإمارات لمضايقات الوهابيّين، ويخشون حضور مراسم العزاء؛ خوفاً من طردهم من الإمارات([193]).
وللشيعة في قطر مآتم وحسينيات يبلغ عددها حوالى عشر حسينيّات، يقيمون فيها العزاء على سيّد الشهداء الحسين بن علي، وتفتح الحسينيّات أبوابها طيلة شهر محرّم وصفر ورمضان، وأيام وَفَيات الأئمّة، ومواليدهم، أمّا في مآتم النساء فهناك بعض التشابيه، مثل قُبَّة العبّاس وخيمة القاسم([194]).
وفي سلطنة عمان يقيم الشيعة مراسم العزاء على الحسين بن علي في حسينيّاتهم ومساجدهم أيام شهري محرّم وصفر، ولهم مطلق الحريّة في إقامة طقوس العزاء على الحسين. ولم تتدخّل السلطات في مراسم العزاء، بل العمانيّون الشيعة لهم الحريّة الكاملة في إقامة شعائرهم الدينيّة، ويحظَون باحترام كافّة المذاهب في السلطنة([195]).
الفصل الثالث
يقيم الإيرانيّون في شهرَي محرّم وصفر مجالس العزاء، ويتحدّث الخطباء عن واقعة كربلاء، ويصفون ملحمة الطفّ، وما قام به الحسين بن علي× وأصحابه وأهل بيته من بطولات في مواجهتهم لجيش يزيد بن معاوية، واستشهادهم في كربلاء، وأخذ أهل بيت الحسين أسرى إلى الشام. ويروون عن الأئمّة من أهل البيت روايات تؤكّد وجوب الحزن والبكاء على الحسين، عكس ما يراه أهل السنّة، حيث يحرّم البعض من فقهائهم البكاء على الميت. وتخرج مواكب العزاء في المدن وتسير في الشوارع، ويلطم المشاركون صدورَهم، ويضربون على ظهورهم بالسلاسل حزناً على الحسين بن علی×.
ويُعِدّ الشيعة العزاء على الإمام الحسين (تعظيماً للشعائر الإلهيّة) ويرون التعزية مصداقا للآية الكريمة (...وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)([196]). كما يرون أنّ إقامة مجالس العزاء علی الحسين هي المودّة لذي القربى في الآية الكريمة: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)([197]).
وينقل الإيرانيّون الروايات عن أئمة أهل البيت في وجوب الحزن والبكاء على الإمام الحسين بن علي×، ومنها ما نُقل عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين([198]) القول: «أيّما مؤمن دمعت عينه لقتل الحسين حتى تسيل على خديه، بوَّأه الله بها في الجنّة غرفا يسكنها أحقابا»([199]). ونُقل عن الإمام جعفر الصادق×([200]) قوله لأحد أصحابه: «يا فُضيل تجتمعون وتتحدّثون؟ قال: نعم سيّدي، قال الإمام: أحيوا أمرَنا رحم الله من أحيا أمرنا، والله إنّ تلك المجالس أحبُّها. وقال: إنّ البكاء والجزع مكروه للعبد، في كلّ ما جزع، ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن علي فإنّه مأجور»([201]).
ويخصّص الشيعة فی إيران شهر محرّم لإقامة مراسم العزاء والحزن والبكاء علي الحسين بن علي×، ويبدأون شهر محرّم بإقامة مجالس العزاء والخروج بمواكب اللطم والزنجيل والشبيه في المدن الإسلاميّة، وتستمرّ هذه المراسم والتقاليد خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم حتى يوم عاشوراء ذكرى مقتل الحسين بن عليّ وأصحابه وأهل بيته. ففي الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم يلبس الشيعة اللباس الأسود؛ حزناً على الحسين بن علي، ويقيمون مجالس العزاء في البيوت والمساجد والحسينيّات ويعتلي الخطباء المنابر ويتحدّثون عن واقعة كربلاء منذ خروج الحسين من مكّة وتوجّهه إلى المدينة، ومنها إلى كربلاء واستشهاده فيها، وعن أخذ أهل بيته سبايا إلى الكوفة، ومنها إلى الشام والمدينة.
ويخصّص الشيعة الإيرانيّون عشرة أيام من شهر محرّم لإقامة العزاء وشرح واقعة كربلاء، ويقوم الخطيب بسرد واقعة كربلاء بتفاصيلها، ويدعم كلامه بأشعار الشعراء الذين رَثَوا الحسين طوال القرون الماضية، كذلك يرتقي الرواديد أو النائحون المنابر، ويقرأون المراثي الحسينيّة ويلطم الحاضرون على صدورهم. وقد نظم الشعراء الشيعة الإيرانيّون طوال القرون الماضية قصائد في رثاء الحسين، ولا زالت هذه الأشعار تُقرأ على المنابر ويحفظها الناس عن ظهر قلب.
تُعدّ إيران من أوائل الدول التي دخل إليها الإسلام بعد الجزيرة العربيّة، وذلك في منتصف القرن الأوّل الهجريّ، حيث اعتنق الإيرانيّون الإسلام، وقدّموا خدمات عظيمة للإسلام على طول التاريخ الإسلاميّ، ويظهر ذلك بجلاء في علمائهم الذين احتلّوا الصدارة بين علماء المسلمين وبكلّ أصناف العلوم من تاريخٍ وفلسفةٍ وحديثٍ وفقهٍ وكلامٍ وعرفانٍ وأدب.
ينقل المؤرّخون أنّ الإسلام دخل إلى إيران من دون حروب وقتال، وانتشر الإسلام خلال عشرين عاماً في أنحاء إيران من ساحل الفرات وحتى نهر جيحون، ومن تخوم السند حتى سواحل بحيرة خوارزم، وأسلم الإيرانيّون في طول البلاد وعرضها باستثناء جبال مازندران وديلمان، وعملوا على نشر الدين الجديد([202]).
كان الكثير من الإيرانيّين في أواخر القرن الأوّل للهجرة والقرن الثاني يذهبون إلى الكوفة لتعلّم الحديث، وكانت مدينة الكوفة مركزاً للشيعة، كما «انتشر المذهب الشيعيّ بين الإيرانيّين المهاجرين. وعندما عاد هؤلاء إلى إيران نقلوا معهم تعاليم المذهب الشيعيّ إلى بلادهم»([203]).
انتشر التشيّع بين المَوالي والفرس، ويفسّر كثير من المستشرقين ذلك بزواج الحسين بن علي بإحدى بنات يزدجرد آخر ملوك بني ساسان، فكان علي بن الحسين زين العابدين ابن الخيرتَين مصداقاً لقول رسول الله: «لله من عباده خيرتان فخيرته من العرب قريش وخيرته من العجم فارس»([204]).
كان أحد أسباب انتشار التشيّع في إيران هو وجود المَوالي (من غير العرب) الذين نقلوا تعاليم المذهب الشيعيّ من الكوفة إلى إيران، وعلى الرغم من معاملة الأمويّين السيئة للمَوالي، فإنّ الإيرانيّين واصلوا العمل بالتعاليم الإسلاميّة. لقي الموالي الحرمان في عصر صدر الإسلام، ولكنّهم عُومِلوا معاملة إنسانيّة خلال حكم الإمام عليّ، وكانت هذه المعاملة قد أثّرت فيهم وشجّعتهم على التشيّع لعليّ ودعم العلويّين، ودخولهم في جيش المختار بن عبيدة الثقفيّ للانتقام من قتلة الحسين بن علي×.
فالمختار كان يعتمد على الموالي؛ لأنّهم لم يشاركوا في قتل الحسين، بل كانوا من محبيّ أهل البيت وأنصارهم، كما كان لديهم الدافع السياسيّ للتخلّص من ظلم بني أميّة([205]).
انتشر المذهب الشيعيّ في مناطق كثيرة من إيران وكانت قمّ أوّل مركز للتشيع. ويعود تشيّع هذه المدينة إلى أواخر القرن الأوّل للهجرة، وقد سار أهالي قم على مذهب أهل البيت؛ أي كانوا شيعة اثني عشريّة.
انتقل المذهب الشيعيّ إلى مناطق أخرى من إيران؛ منها آوه أو آبه وكان أهل هذه المدينة في نزاع دائم مع أهالي ساوه التي كان أهلها على المذهب السنيّ. وعُرفت مدينة الريّ التي فتحها المسلمون في العام 22 للهجرة على أنّها إحدى قلاع الشيعة، كما كانت كاشان مدينة يسكنها الشيعة. وكانت فراهان إحدى المدن الشيعيّة، وقد وصف حمد الله المستوفي في كتابه (نزهة القلوب) أهالي فراهان بأنّهم شيعة متعصّبون. كما أنّ تفرش كانت ضمن المناطق التي يسكنها الشيعة، وهي قريبة من قم. وكانت خراسان ومرو وبيهق التي كان مركزها سبزوار تقع شمال شرقيّ إيران ويسكنها الشيعة([206]).
كانت مدينة خراسان مركزاً من مراكز الشيعة، وكان يسكنها العلويّون وعندما تغلّب المأمون على أخيه الأمين سعى إلى كسب ودّ أهالي خراسان ودعمهم، ولهذا السبب طلب المأمون من الإمام علي بن موسى الرضا× أن يأتي من المدينة إلى خراسان ويتولّى منصب وليّ العهد. وذكر ابن خلدون أنّ المأمون دعا الإمام علي بن موسى الرضا إلى خراسان لتولِّي منصب وليّ العهد، لأنّ أكثرية أهالي خراسان كانوا من الشيعة([207]).
نقل لنا كتاب (أبو مسلم نامه) أنّ أبا مسلم الخراسانيّ وبعض أنصاره الذين كانوا يستهدفون إسقاط الدولة الأمويّة، كانوا يعلنون أنّهم يريدون الأخذ بثأر الحسين، وكانوا يحرّضون الناس ضدّ الأمويّين، أثناء المعارك التي كانوا يخوضونها ضدّ الجيش الأمويّ، وكانوا يقرأون أشعاراً في رثاء الحسين بن علي. ولكنّ هدفهم كان السيطرة على الحكم وليس حبّاً بالحسين([208]).
یرى كاتب إيرانيّ بأنّ حبّ الإيرانيّين لأهل بيت رسول الله| وإقامة العزاء على الحسين وعرض فاجعة كربلاء يعود إلى شعور الإيرانيّين بمصاهرة أهل البيت وقربهم منهم. وكان الإمام الحسين بن علي قد تزوَّج من شهربانو([209]) وهي أمّ الإمام زين العابدين علي بن الحسين، كما أنّ سلمان الفارسيّ وهو إيرانيّ كان من صحابة رسول الله وجاهد معه. ويضيف الكاتب بأنّ أهالي كازرون وهي المدينة التي ولد فيها سلمان الفارسيّ يعتقدون بأّنهم قريبون إلى الحسين وأهل بيته([210]). وهذا ليس سبباً كافياً؛ لأنّ أمّهات العديد من المناوئين لأهل البيت كنّ من السبايا الإيرانيّات وعبيد الله بن زياد نفسه كانت أمّه فارسيّة وكان يلحن في كلامه([211]).
ويروي صاحب كتاب (سير تاريخي تعزيه در كازرون) [المسار التاریخيّ للتعزية في كازرون] بأنّ سلمان الفارسيّ([212]) تنبّأ بقتل الحسين عندما مرّ بأرض كربلاء وسأل من كان معه ما اسم هذه الأرض؟ قالوا له بأنّها تُسمَّى كربلاء، عندها قال سلمان الفارسيّ بأن كربلاء ستكون الأرض التي سيُقتل فیها الإمام الحسين×([213]).
بدأ الشيعة أيام حكم الأمويّين إقامة مراسم النواح والحداد على الحسين بن علي× في يوم عاشوراء، بينما كان الأمويّون يلبسون في هذا اليوم ثياباً جديدة ويتزيّنون ويتكحّلون، ويقيمون الولائم ويقدّمون الأطعمة والحلويات. ويقول أبو الرَّيحان البِيروني حول عاشوراء: «فأمّا بنو أميّة، فقد لبسوا فيه ما تجدّد وتزيَّنوا واكتحلوا وعيّدوا وأقاموا الولائم والضيافات وأطعموا الحلاوات والطيبات وجرى الرسم في العامّة على ذلك أيام مُلكهم وبقي فيهم بعد زواله عنهم. وأمّا الشيعة فإنّهم ينوحون ويبكون أسفاً لقتل سيّد الشهداء»([214]).
يقول المؤرّخ الإيرانيّ
محمّد إبراهيم باستاني باريزي «إنّ قضيّة عاشوراء وواقعة مقتل
الحسين، لا تخصّ الشيعة ولا السنّة، بل إنّ هذه القضية تخصّ جميع المسلمين،
لم يفعل يزيد خيراً مع أبناء الرسول|، وقد ثار البعض منهم في مدينة سيستان([215])
الإيرانيّة، وطردوا والي بني أميّة وهو عبّاد بن زياد من مدينتهم، ولكنّ أخا
الوالي وهو يزيد بن زياد وبعده عبيدة بن زياد عادا إلى المدينة، لأنّ أخاهما عبيد
الله بن زياد (والي يزيد على الكوفة في العام 61هـ) كان هو الذي دبّر واقعة
عاشوراء وكان سبباً في قتل الحسين»([216]).
ويضيف باستاني باريزي: «في العام 61هـ، لم يكن أهالي سيستان شيعة، فقضيّة عاشوراء كانت حدثاً جللاً، ولذلك كان ردّ فعلهم عليها، ففي تلك السنوات كانت واقعة عاشوراء تثير ردود فعل في جميع أنحاء إيران»([217]). ويرى أنَّ الثورات التي وقعت في إيران بعد دخول الإسلام إليها، كانت تتكلّل بالنجاح عندما كانت تقع في شهر محرّم وفي أيّام عاشوراء([218]).
في القرن الثاني للهجرة وبالتحديد في العام 110هـ/728م وقعت حادثة في مدينة فين في كاشان (وسط إيران) استُشهد خلالها السلطان عليّ ابن الإمام محمّد الباقر الذي دعاه أهالي مدينة فين إلى مدينتهم ليتولّى زعامتهم الدينيّة، علماً أنّ مدينة كاشان الإيرانيّة كانت في القرن الثاني للهجرة أحد معاقل الشيعة. ولكنَّ السلطان عليّ قُتل وهو في طريقه إلى كاشان قبل أن يصل إلى هذه المدينة، وعندما وصل خبر مقتله إلى أهلها هرعوا إلى مكان مقتله، ووجدوا جسده مقطّعاً، فحملوه وجاؤوا به إلى نهر كان هناك وغسّلوه وكفّنوه ولفّوه في سجادة، وحملوه إلى مقبرة المدينة ودفنوه، ولا يزالون يحتفظون بتلك السجادة حتى الآن([219]).
يقيم أهالي مدينة فين منذ القرن الثاني الهجريّ ـ وحتى الآن في يوم الجمعة من منتصف شهر مهر الإيرانيّ (أكتوبر ـ تشرين الأوّل) من كلّ عام ـ مراسم عزاء في قرية أردهال يرفع فيها بين 300 و400 من أهالي المدينة عصاً غليظة؛ تعبيراً عن الجهاد في سبيل الله، ويردّدون شعارات حماسيّة ضدّ أعداء أهل البيت، ويحملون السجّادة التي حملوا فيها جسد السلطان عليّ، ويغسلونها في نهر أردهال مثلما فعل أجدادهم سابقاً، وبعد ذلك يعيدونها إلى مكانها داخل ضريح السلطان عليّ. حادثة استشهاد السلطان عليّ تشبه إلى حدّ ما استشهاد الحسين في كربلاء عندما دعاه أهل الكوفة وخذلوه. ويشهد هذه الواقعة ومراسم العزاء كلّ عام أكثر من خمسة عشر ألف شخص من أهالي المدينة والمدن والقرى المجاورة([220]).
وفي مدينة همدان ـ الواقعة إلى الشمال الغربيّ من إيران، التي كانت مأوى لجيش الترك ومأمنهم، ويعيش فيها أهل السنة ـ «أقام مجد الدين مذكر الهمدانيّ العزاء في موسم عاشوراء، بحيث جعل أهالي قم يندهشون منه». ويتحدّث صاحب كتاب (النقض) عبد الجليل القزوينيّ الرازيّ عن نيسابور وإمامها الخواجة نجم أبي المعالي بن أبي القاسم البزاري ويقول «مع أنّه كان حنفيّ المذهب، إلّا أنَّه كان يقيم العزاء بكلّ قوّة، وكان يأخذ كتاباً بيده ويقرأ التعزية، وينثر التراب على رأسه، ويطلق الصرخات والعويل». وفي مدينة الرّيّ كان الشيخ أبو الفتوح نصر آبادي والخواجة محمود حدادي حنفيَّي المذهب «فقد فعلا ما فعلاه في يوم عاشوراء من ذكر العزاء ولعن الظالمين وذلك في نزل كوشك والمساجد الكبرى»، «والقاضي عمده ساويي الحنفي الذي كان صاحب حديث ومعروف، وقد روى هذه القصّة في جامع طغرل بحضور عشرين ألف إنسان وأقام العزاء وحسر رأسه وشقّ جيبه، ولم يفعل أحد ما فعله في هذا اليوم»([221]).
وذكر ياقوت الحمَويّ أنّ الشيعة في مدينة كاشان (وسط إيران) أقاموا مراسم العزاء([222])، في القرن السادس الهجريّ.
ومن المراسم التي كان يقيمها الشيعة في العصر الإيلخانيّ وذكرها ابن بطوطة في رحلته، (مراسم صاحب الزمان)([223]). ويقول ابن بطوطة عن إقامة هذه المراسم في مدينة الحلة في العراق: «بالقرب من سوق المدينة الكبير يوجد مسجد معلّقٌ على بابه ستار من الحرير، ويسمّون ذلك مشهد صاحب الزمان. في المساء وبعد صلاة العصر يذهب مائة رجل مسلّح بالسيف عند أمير المدينة، ويأخذون منه فرساً ويتوجّهون نحو مشهد صاحب الزمان. وقبل الوصول إلى المشهد تنطلق فرقة تضرب الطبل والأبواق، وينقسم الرجال إلى قسمين: قسم يسير أمام الفَرَس، وقسم يسير وراءه، ويمشي الناس على يمين الفرَس ويساره حتى يصلوا إلى مسجد صاحب الزمان. وعند وصولهم إلى المسجد يقرأون الدعاء التالي: بسم الله يا صاحب الزمان، بسم الله اُخرج لأنّ الظلم قد عمّ المعمورة، فقد حان الوقت لكي تأتي ليفرّق الله بواسطتك بين الحق والباطل، وهكذا تستمرّ الفرقة بضرب الطبول والأبواق حتى موعد أذان المغرب. ويعتقد أهل الحلّة بأنّ محمّدّاً بن الإمام الحسن العسكري، دخل المسجد، وغاب فيه وسوف يظهر قريباً منه ويسمّونه الإمام المنتظر»([224]).وأُقيمت مراسم عزاء الحسين× بعد سقوط الإيلخانيّين المغول (703ـ736هـ/1304ـ1336م) وتشكيل الحكومات المحلّية في إيران بحريّة أكبر، لا سيّما وأنّ الحكومات المحليّة مثل سربداران خراسان، ومرعشية مازندران([225]) وآل كيا في جيلان([226]) كانت حکومات شيعيّة وكان الشيعة يقيمون مراسم العزاء على الحسين على أساس أنّها فريضة.
التشيّع في العصر الصفويّ (1501 ـ 1786م)
حكم الصفويّون إيران من العام 907 إلى 1134هـ/1501 ـ 1786م وحوّلوا إيران إلى قوّة كبرى في المنطقة، وأعلنوا المذهب الشيعيّ المذهب الرسميّ للبلاد، وكان حكم الصفويّين نقطة تحوّل في تاريخ إيران، ومرحلة جديدة في تاريخ الإسلام([227]).
ففي عصر الشاه إسماعيل الصفويّ([228]) (907ـ930هـ/1501ـ 1524م) الذي أعلن في مسجد تبريز حين دخلها منتصراً المذهب الشيعيّ المذهب الرسميّ الوحيد لإيران، وُضعت أُسس مراسم العزاء والمراسم الدينيّة الأخرى. كما بُنيت الحسينيّات لإقامة العزاء، ورُسمت صور الأئمّة والأولياء على جدرانها. وازدهرت طقوس العزاء، ونظم الشعراء قصائد في مدح الإمام الحسين بعدما كان الشعراء يمدحون الملوك، كما أُقيمت مراسم العزاء على الإمام الحسين، وزار الشاه إسماعيل الصفويّ بعد السيطرة على بغداد في العام 914هـ/1508م)، مدينتي كربلاء والنجف الأشرف حيث ضريحا الإمام الحسين والإمام علي×، كما زار مدينة الكاظميّة بالقرب من بغداد حيث مرقد الإمامين موسى الكاظم× ومحمّد الجواد×، وقدّم هدايا ثمينة للمراقد التي زارها([229]).
«أصدر الشاه إسماعيل الصفويّ أمراً بأن يضيف المؤذّنون إلى الشهادتين (أشهد أنّ عليّا وليّ الله)» و«حيّ على الفلاح» و«حيّ على خير العمل»، و«محمّد وعليّ خيرُ البشر»([230]). هاجر عدد من علماء جبل عامل بتشجيع من الدولة الصفويّة، إلى إيران، هرباً من ضغط العثمانيّين، وتمتّعوا بالحرية الدينيّة والسياسيّة المطلقة، ولا سيّما في زمن الشاه طهماسب([231]). جاء الشيخ علي بن الحسين بن علي بن محمّد بن عبد العالي الكركيّ العامليّ (المحقّق الكركيّ)، أو المحقّق الثاني المتوفّى في العام 940هـ/1533م) من علماء جبل عامل إلى إيران، ولقي دعماً من بلاط الشاه طهماسب وأمر الشاه أن يستقرّ الشيخ في مدينة كاشان من أجل أن ينشر تقاليد الشيعة في هذه المدينة. وقام الشيخ بنشر وتوسعة هذه الطقوس الدينيّة في المدينة، واشتهرت مدينة كاشان باسم (دار المؤمنين). وبذل الشيخ جهوداً كبيرة لإقامة المراسم الدينيّة وخاصّة في ليالي شهر رمضان المبارك وليالي القدر.
العزاء في العصر الصفويّ (907 ـ 1135هـ)
منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه الشاه إسماعيل الصفويّ([232]) (907 ـ 930هـ) تاسيس الدولة الصفوية، واعتبار المذهب الشيعيّ المذهب الرسميّ الوحيد لإيران، وُضعت أُسس مراسم العزاء الحسيني، وبنيت الحسينيّات لإقامة العزاء، ورُسِمت صور الأئمّة والأولياء على جدرانها. وازدهرت طقوس العزاء، ونظم الشعراء قصائد في مدح الإمام الحسين بعدما كان الشعراء يمدحون الملوك، وقام الشاه إسماعيل الصفويّ بزيارة مدينتي كربلاء والنجف الأشرف، فكان لتلك الزيارة دور في توجيه الأُمَّة نحو العزاء الحسيني.
وتزامن مع قيام الدولة الصفوية ظهور أوّل كتاب بالفارسيّة حول مقتل الحسين ابن عليّ سُمّيَ (روضة الشهداء)، كتبه الملا حسين واعظ كاشفي (840 ـ 910هـ) الذي عاصر من الدولة الصفوية ثلاث سنين فقط، وكان لهذا التزامن دوره في ترويج الكتاب، وبالتالي ترويج العزاء الحسيني؛ حيث أدخل هذا الكتاب قراءة المقتل إلى مجالس العزاء في إيران، فشكَّل ذلك تحوُّلاً في العزاء الحسيني.
وفي عصر الشاه طهماسب (930 ـ 984هـ/ 1524 ـ 1576م) الذي حكم إيران مدّة ثلاثة وخمسين عاماً ـ ازدهرت الشعائر الحسينية ومظاهر العزاء واخذت بالانتشار والتنوع، وكانت الدولة ترعى ذلك وتشجِّع عليه.
وشجّع الشاه طهماسب الشعراء على مدح الأئمّة والأولياء، وذكر مناقب أهل البيت، وذكر واقعة كربلاء، ومنعهم من مدحه. وفي هذا العصر برز شعراء كبار اشتهروا بشعر الرثاء؛ ومنهم الشاعر مولانا محتشم الكاشانيّ الذي اشتهر بقصيدته التي مطلعها:
باز این چه شورش است؟ که در خلق عالم است باز این چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است؟
الترجمة:
ما هذا الاضطراب الذي غمر العالم؟ وما هذا النواح وهذا العزاء وهذا المأتم؟
رثى الشاعر محتشم الكاشانيّ الإمام الحسين، ووصف واقعة كربلاء بقصيدة مشهورة وعصماء لا يزال يردّدها الرواديد والنائحون على المنابر، وسار الشعراء من أقرانه على طريقته.
لا يوجد في هذا العصر شاعر لم يمدح الرسول| والأئمّة ولم يصف واقعة كربلاء. وكان شعراء من أمثال نظام استرآبادي (المتوفّى في العام 921هـ/ 1515م) وأهلي الشيرازيّ (المتوفّى في العام 942هـ/1536م) ولساني الشيرازيّ (المتوفى في العام 940هـ/1534م) قد نظموا قصائد في مدح ورثاء أهل البيت. وكان الشاعر حيرتي توني (المتوفّى في العام 961هـ/ 1554م) قد بزّ شعراء عصره، وعُرف الشاعر حسن الكاشي بمدائحه لأهل البيت. وفي هذا العصر انتشر بين الشعراء شعر رثاء أهل البيت، وامتدّ ذلك حتى العصر القاجاريّ([233]).
فإلى جانب مجالس العزاء التي كانت تُقام في مدينة إصفهان عاصمة الصفويّين، كانت تخرج المواكب إلى الشوارع، وتمثّل واقعة كربلاء، وتسير الجمال والسيوف معلّقة عليها، كما كان المعزّون يحملون التوابيت؛ إشارةً إلى استشهاد الحسين وأهل بيته في يوم عاشوراء.
كان الشاه عبّاس الصفويّ (996 ـ 1038هـ/1588 ـ 1629م) يقيم مراسم العزاء في (ساحة نقش جهان) في مدينة إصفهان ويشارك هو نفسه في هذه المراسم. كما أنّه دعا السفراء الأجانب المعتمدين في بلاطه سواء كانوا مسلمين أم مسيحيّين إلى المشاركة ومشاهدة المراسم. ولم يتوقّف الشاه عبّاس الصفويّ عن إقامة مراسم العزاء حتى في اثناء خوضه الحروب ضدّ العثمانيّين.
وفي العصر الصفويّ، اعتاد الإيرانيّون على زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا× في مدينة مشهد (شمال شرقيّ إيران) مشياً على الأقدام؛ تأسّياً بملوك الصفويّين، ومنهم الشاه عبّاس الصفويّ (الأوّل) الذي كان يذهب من مدينة إصفهان إلى مدينة مشهد مشياً على الأقدام مثلما كان يفعل جدّه الشاه إسماعيل الأوّل. فقد قطع الشاه عبّاس المسافة بين إصفهان وخراسان مشياً على الأقدام في ثمانية وعشرين يوماً، وذلك في العام 1010هـ/1602م([234]). وكان الشاه يحتفل بولادة أئمّة أهل البيت، ويقيم مجالس العزاء بمناسبة وفياتهم. كما كان يقيم العزاء يوم عاشوراء، ويوم الحادي والعشرين من شهر رمضان يوم استشهاد الإمام علي ابن أبي طالب×.
اشتهر الشاه عبّاس الصفويّ بحبه للعمارة؛ وبنى مسجد الشاه في العام 1012هـ/1603م، كما بنى مسجد شيخ لطف الله في العام 1020هـ/1611م، في إصفهان. وقام الشاه عبّاس الصفويّ بإعادة ترميم مرقد الإمام علي بن موسى الرضا× في مدينة مشهد، وقدّم هدايا كبيرة([235]).
العزاء في العصر القاجاريّ (1174 ـ 1304هـ/1796 ـ 1925م)
يتفق الكتّاب الإيرانيّون على أنّ الاهتمام بمراسم العزاء في العصر القاجاريّ كان له دوافع وأسباب؛ جعلت الحكام والسلاطين يتبارَون في إقامتها والتشجيع عليها. ويطرح الدارسون أسباباً ودوافع عديدة وراء إقامة العزاء على الحسين في هذا العصر.
ويرى الكاتب الإيرانيّ علي بلوكباشي أنّ اقامة العزاء في العصر القاجاريّ قد تطوّرت وتوسّعت؛ نظراً لاهتمام السلاطين القاجار، وعلى رأسهم فتحعلي شاه القاجاريّ الذي كان رجلاً متديّناً، أو أنّه كان يتظاهر بالتديّن، وهو الذي كان يقيم مجالس العزاء ويشجِّع وزراءه ورجال البلاط على إقامتها، وهم كانوا يقيمون مجالس العزاء على الحسين ويشجّعون الآخرين على إقامتها([236]).
«وكانت لهؤلاء أسبابهم ودوافعهم في إقامة العزاء، منهم من كان يشعر بأنّ عليه دَيناً يؤدّيه، أو أنّه نذر للحسين ليحصل على مبتغاه، وهو بذلك يريد وفاء نذره، أو أنّه يريد بهذا أن يتقرّب إلى الله؛ ليخفّف من ثقل معاصيه ويلطّف روحه، والبعض كان يقيم العزاء من أجل كسب وجاهة ونفوذ دينيّ بين الآخرين وبين عامّة الناس، والبعض كان يقيم العزاء منافسة لغيره، أو إظهارا لثروته أو قدراته الماليّة»([237]). كان الحاج محمّد حسين خان أمين الدولة المعروف بصدر الإصفهانيّ وزيراً للشؤون الماليّة في عهد السلطان فتحعليشاه قاجار، وكان يقيم مجلس العزاء في العشرة الأولى من شهر محرّم من كلّ عام في منزله.
ففي العام 1268هـ/1852م ـ أي بعد أربع سنوات من وفاة الحاكم القاجاريّ محمّد شاه وبداية حكومة ناصر الدين شاه ـ كانت في طهران 54 تكيّة ومسجداً بالاضافة إلى 5 مقابر لأبناء الأئمّة. وكانت تُقام فيها مراسم العزاء، ويتجمّع المواطنون فيها للمشاركة في هذه المراسم. كان عدد سكّان طهران آنذاك یبلغ 155736 نسَمة وكان هؤلاء يسكنون في خمس محلّات وبعضهم يسكن خارج المدينة([238]).
رواية السيّاح والمستشرقين الأوروبيّين عن العزاء في العصرين الصفويّ والقاجاريّ
كان للسيّاح الغربيّين الذين زاروا إيران، وللدبلوماسيّين، ومبعوثي الدول الأجنبيّة في البلاط الإيرانيّ في العهدَين الصفويّ والقاجاريّ دورٌ كبير في نقل مشاهد العزاء في إيران، ولو لم يكتب هؤلاء مذكّراتهم بعد أن زاروا إيران أو أقاموا فيها لما تمكّنا من معرفة مراسم العزاء التي كانت تجري في إيران في العصرين الصفويّ والقاجاريّ خلال شهرَي محرّم وصفر، ولا سيّما خروج مواكب العزاء والشَّبيه، وكذلك إقامة عروض التعزية في التكايا والمساجد والحسينيّات في طهران والمدن الإيرانيّة الأخرى.
ولا يغيب عن البال أنّ السيّاح الأوروبيّين والدبلوماسيّين الأجانب المعتَمدِين لدى بلاط الملوك الصفويّين والقاجاريّين وكذلك المستشرقين الأوروبيّين الذين زاروا إيران، كتبوا دراسات مستفيضة عن المذهب الشيعيّ وعاشوراء، وأغنوا المكتبة العالميّة بالدراسات المستفيضة.
ونظراً لقلّة الكتب ـ التي كتبها كتّاب إيرانيّون عن العزاء في إيران طوال العصور الماضية ـ فإنّ مذكّرات السيّاح الأوروبيّين والدبلوماسيّين المعتَمَدِين لدى بلاط الملوك الصفويّين والقاجاريّين أصبحت مصدراً رئيسيّاً لدراسات الإيرانيّين عن التعزية. علماً أنّ كتباً قليلة كتبها كتّاب إيرانيّون في العصرين الصفويّ والقاجاريّ عن أوضاع إيران في هذين العصرين، مشيرين إلى مراسم العزاء من دون الدخول في التفاصيل، ومن أبرز هذه الكتب كتاب (تاريخ عالم آراي عبّاسي) [تاريخ العالم في عصر الشاه عبّاس الصفويّ] لمؤلّفه اسكندر بيك منشي الذي کان أمين السِّرِّ لدى الشاه عبّاس الصفويّ، وتوفّی في العام 1629.
تحدّث المؤلّف عن عصر الشاه عبّاس الصفويّ، وأشار إلى إقامة مراسم العزاء في هذا العصر. وهناك كتاب آخر بعنوان: (شرح زندگانی من تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجاریه) [سيرة حیاتي، التاریخ الاجتماعيّ والإداريّ في العصر القاجاريّ] للكاتب عبد الله المستوفي، وهو يتحدّث عن العصر القاجاريّ، واقامة مراسم العزاء في هذا العصر.
ونقل السيّاح الغربيّون والمبعوثون الأجانب في بلاط ملوك الصفويّين والقاجاريّين مشاهد العزاء، بكلّ تفاصيلها إلى القرّاء الأوروبيّين في كتب الرحلات التي كتبوها في القرن السابع عشر وما بعده، وتُرجِمت هذه الكتب إلي الفارسيّة، ويعتمد عليها الكتّاب والباحثون الإيرانيّون في بحوثهم وكتاباتهم عن العزاء في عاشوراء. زار السائح الايطاليّ بيترو دلا فاله([239]) في العام 1032هـ/1622م مدينة إصفهان عاصمة الدولة الصفويّة في عهد الشاه عبّاس الصفويّ، وكتب عمّا شاهده من مجالس العزاء في شهر محرّم، ما يلي: «يبدو على الجميع الحزن والهمّ، ويلبسون السواد، ولا يحلقون رؤوسهم ولحاهم وذقونهم، ولا يغتسلون، ولا يمتنعون فقط عن المعاصي، بل يحرمون أنفسهم من كلّ تسلية وترفيه. الجميع يحاول أن يظهر حزنه على الإمام الحسين»([240]).
ويشرح بيترو دلا فاله مجالس العزاء في إصفهان ويقول: «يعتلي خطيب المنبر الذي يشرف على الحضور رجالاً ونساءً، والخطيبُ هو في الغالب سيدٌ من أهل بيت رسول الله ويعتمر عمامة خضراء. وفي تركيا يُطلق على هؤلاء السادة اسم (الأمير) وفي مصر يطلق عليهم اسم (الشريف)، ويبدأ الخطيب قراءة التعزية ويصف واقعة كربلاء التي استُشهد فيها الحسين، والخطيب يسعى إلى إبكاء الحضور»([241]).
«تُقام هذه المراسم صباحاً في المساجد ومساء في الأماكن العامّة وبعض المنازل، حيث تضاء المصابيح، وتعلّق الأعلام السوداء؛ حداداً على استشهاد الحسين. فالحاضرون في هذه المجالس يبكون بصوت عالٍ، ويذرفون الدموع على الحسين لا سيّما النساء اللاتي يلطمنَ صدورهنَّ ويكرّرنَ الجملة الأخيرة التي يردّدها الخطيب، وهم يردّدون: (آه حسين، شاه حسين)»([242]).
ويضيف بيترو دلا فاله «عندما يحلّ اليوم العاشر من محرّم، أي يوم قتل الحسين، يخرج أهالي إصفهان من محلّاتهم في مواكب كبيرة، يحملون الأعلام، ويضعون السيوف على الخيول، كما يضعون العمائم، ويسيّرون عدداً من الجمال يضعون عليها صناديق مغطّاة بالمخمل الأسود، كما يرفعون تابوتاً عليه سيوف، ويدورون به في المدينة، ويرافق حركة هذه المواكب موسيقى جنائزيّة حزينة. فالعديد ممّن يحملون أطباقاً يدورون حول أنفسهم. ويمشي إلى جانب هؤلاء رجال يحملون عصيا غليظة، وهم مستعدّون للدخول في نزاع مع المواكب الأخرى من أجل أن يتقدّم موكبهم قبل غيره، وهم يعتقدون أنّه إذا استُشهد أحدهم خلال مراسم عاشوراء فإنّه سيدخل الجنّة. وحتى إنّ البعض يعتقد أنّه إذا ما توفّي مسلم في شهر محرّم فإنّه سيدخل الجنّة. مراسم عزاء الحسين هي نفسها مراسم استشهاد الإمام عليّ، ولكنّ الفرق بين الإثنين هو أنّ مراسم عزاء الحسين تكون أكبر وعدد المواكب أكثر. واللافت للنظر منظر الرجال الذين يرتدون السواد وفي أيديهم العصي»([243]).
وخلاصة الأمر أنّ الدولة الصفويّة شجَّعت الناس على إقامة مراسم ومجالس العزاء على الحسين بن علي، كما أنّ تسيير مواكب العزاء واللطم والنياحة في أيام شهر محرّم وصفر وشهر رمضان أصبح عادةً عند الشيعة في إيران منذ ذلك التاريخ حتّى الآن.
ويرى مؤلِّف كتاب (شيعه در تاريخ إيران) [الشيعة في تاريخ إيران]، أنّ ملوك الدولة الصفويّة كانوا يظهرون الرغبة الكبيرة بإقامة مجالس العزاء، وكانوا هم يشاركون فيها، وأنَّ إقامة مجالس العزاء بدأت منذ العصر الصفويّ في إيران وبقيت حتى الآن. ولكنّ مسرح الشَّبيه وإقامة مجلس التعزية تمّ تداوله بعد الدولة الصفويّة، وفي عهد (ناصر الدين شاه القاجاري)([244]).
يقول المؤرّخ الإيرانيّ إسكندر بيك منشي([245]): انتشرت التعزية في عهد الشاه عبّاس الأوّل. وفي العام 1021هـ/1612م وتزامن شهر محرّم مع أيام عيد نوروز ولبس الشاه عبّاس الأوّل الأسود؛ حداداً على سيّد الشهداء الحسين بن علي وأقام مجالس العزاء أيام عاشوراء. وأعفى الشيعة في كلّ البلدان من دفع الضرائب بهذه المناسبة([246]).
ويضيف: «أقام جيش الشاه عبّاس مراسم العزاء ليلة عاشوراء، عندما كان يحاصر قلعة إيروان، فسمع المحاصرون في القلعة جلبة وضوضاء وأصوات الجيش وهم يردّدون الشعارات، فظنّوا أنّ الجيش يريد الهجوم عليهم، وكان هناك معترضون على إخلاء القلعة وتسليمها للجيش الصفويّ، ولكنّهم عند سماعهم الجلبة والضوضاء وافقوا على تسليم القلعة، وطلبوا إلى شريف باشا أن يسلّم القلعة للجيش الصفويّ، وأرسل شريف باشا حسن جاووشي باشا برسالة إلى الشاه أعلن فيها أنّه سيُخلي القلعة في اليوم نفسه»([247]).
«شجّع الشاه عبّاس الأوّل الشعراء على نظم الشعر في رثاء الحسين بن علي، وانتشر شعر الرثاء في عصره انتشاراً واسعاً. قدّم الشاه عبّاس في أحد مجالسه جائزة إلى الشاعر مولانا وجيه الدين شاني (تكلو)؛ لأنّه قرأ شعراً في مدح الإمام عليّ، وبحضور سفير الدولة العثمانية والأزبك أمر الشاه عبّاس أن يضعوا الشاعر في كفة ميزان، ويضعوا في الكفة الأخرى ذهباً، وقدّم الذهبَ جائزةً للشاعر»([248]). كان منح الجوائز للشعراء يشجّعهم على نظم المراثي في الحسين بن علي، فقد ألّف الشاعر حسين بن حسن فارغ كتاب فارغ نامه في العام 1000 للهجرة، وضمّ الكتاب أشعاراً دينيّة في وصف فضائل الإمام عليّ وحروبه. وأهدى الشاعر كتابه إلى الشاه عبّاس الصفويّ. كما أنّ أشعاراً نُظمت في مدح رسول الله| وأهل بيته.
لم يغفل الشاه صفي الصفويّ حفيد الشاه عبّاس (1038ـ1052هـ/ 1629ـ1643 م) عن إقامة مراسم العزاء أيام شهر محرّم، ولا سيّما يوم العاشر منه. وفي العام 1039هـ/1629م عندما سيطرت إيران على العتبات المقدّسة في العراق، قام الشاه صفي بزيارة مرقد الإمام الحسين في كربلاء. وبعدها زار مرقد الإمام عليّ× في النجف وأصدر أمراً بإعمار المرقدَین([249]).
زار السائح الألمانيّ آدم أولئاريوس([250]) إيران، وتحدّث عن مراسم العزاء في شهر محرّم من العام 1016هـ/1637م في مدينة أردبيل (شمال غربيّ إيران): وکتب یقول: «يصادف 13 من أيّار ـ مايو، الأوّل من محرّم وأيام العزاء عند الإيرانيّين، حيث يقيمون مراسم العزاء لمدّة عشرة أيام، حتى العاشر من محرّم المسمّى يوم عاشوراء. هذه المراسم تُقام في إيران، وتقوم الشعوب في البلدان الإسلاميّة الأخرى بتقليدهم. هذا العزاء يُقام في ذكرى استشهاد الحسين بن علي الذي حارب جيش يزيد بن معاوية، وحُوصِر وقُطع عنه الماء، واستُشهد هو وأصحابه. والسبب في أنَّ المراسم تستغرق عشرة أيام، هو أنّ الحسين وأصحابه حُوصروا لمدّة عشرة أيام بينما كان متوجهاً من المدينة إلى الكوفة»([251]).
ويضيف أولئاريوس: «في مدينة أردبيل الإيرانيّة، توجد خمسة شوارع ومحلّات وكلّ محلة فيها عدد من الحرفيّين، حيث تقيم كلّ فئة هيئة عزاء وتشارك في المراسم. فكلّ هيئة تحاول اختيار أفضل الأشعار في رثاء الحسين؛ ليقرأه رادود (نائح) ذو صوت جميل خلال الاحتفال بعاشوراء. وكلّ هيئة تقدّم أحسن الأشعار التي تحظى بتشجيع الآخرين. فكلّ هيئة كانت تمرّ من أمام كبير القوم، وكان المشاركون يردّدون الأشعار والمراثي ويعبِرون، وهذه المراسم كانت تستغرق ساعتين وتنتهي»([252]).
شجّع الشاه عبّاس الثاني (1052 ـ 1077هـ/1642 ـ 1666م) إقامة مراسم العزاء، وسار على خطى أبيه وأجداده في زيارة العتبات المقدّسة، وكانت الزيارة عادة من ضمن عاداته، وكان يقدّم الطعام للفقراء والمساكين. وأصدر الشاه عبّاس الثاني أمراً منع بموجبه شرب الخمر والألعاب المحرّمة التي كانت تقام في البيوت علانية. كما أنّه كان يذهب إلى العتبات المقدّسة مشياً على الأقدام([253]).
زار سائح أوروبيّ آخر، وهو جان باتيست تافرنيه([254]) إيران في القرن السابع عشر ووصف مراسم العزاء، وخروج المواكب التي كانت تمرّ أمام المشاهدين ببطء ويقول: «كان المشاركون في هذه المواكب يلطمون صدورهم، ويستخدمون الزناجيل ويضربون الطبول، ويحملون الأعلام التي لم تكن تشبه آلات الحرب. كما كانوا ينوحون ويذكّرون الناس بواقعة كربلاء»([255]).
وأضاف تافرنيه: «قبل عشرة أيام من يوم عاشوراء، يطلي الشيعة أجسامهم باللون الأسود؛ علامة على حزنهم على الحسين، ويخرجون إلى الشوارع والأزقة، ويردّدون يا حسن يا حسين، وهؤلاء يواصلون ترديد هذه الشعارات حتى غروب الشمس، عندها تُقام الولائم ويُقدَّم الطعام إلى هؤلاء ويصعد الخطباء والوعّاظ المنابر في الشوارع ويلقون الكلمات عن استشهاد الحسين»([256]).
وشاهد تافرنيه خلال زيارته لإيران «خروج مواكب العزاء إلى الشوارع والميادين حيث يرفع كلّ عشرة أشخاص تابوتاً كبيراً مغطىً بقماش أسود، ومزدانا بالورود وعليه رسوم، وهذا التابوت يكون في مقدّمة الموكب؛ حيث يبكي الحاضرون عندما يرون التابوت الذي يرمز إلى حمل أجساد الشهداء. ويضعون في بعض التوابيت طفلاً يرمز إلى استشهاد أطفال الإمام الحسين في يوم عاشوراء على يد الخليفة الأمويّ يزيد»([257]).
تحوّل الشَّبيه الذي كان صامتاً في العصر البويهيّ([258]) إلى شبيه ناطق في العصر الصفويّ الذي استمرّ حتى نهاية القرن السابع عشر، بحيث كان الرجال بملابسهم الملوّنة يمثّلون واقعة كربلاء أمام المشاهدين. وكان من بين من نقلوا مشاهداتهم عن التعزية والشَّبيه في إيران الرحّالة الفرنسيّ روفائيل دومانز في كتابه بالفرنسيّة بعنوان: Raphael Du Mans’ Etat de la Perse en 1660 (Paris’ 1809’ Farnborough’ Hants’1960). [حكومة فارس في العام 1660] حيث نقل مشاهداته عن إيران التي زارها في العام 1660م([259]).
ودوّن السير جان شاردن([260]) في كتابه (رحلة شاردن إلى إيران والهند الشرقيّة من طريق البحر الأسود وكولخيس) ما شاهده في شهر محرّم سنة 1085 هـ/ أبريل ـ نيسان 1674م. وفي هذا التقرير، تحدّث الكاتب عن اتساع نطاق مراسم العزاء في العصر الصفويّ، حيث كانت مواكب العزاء تجوب الشوارع، ويمثّل رجال بملابسهم الملوّنة دورَ شهداء كربلاء، وكان العديد منهم يركب الخيول أو الجمال ويمثّل واقعة كربلاء للمشاهدين. كانت هناك مشاهد تمثَّل على مصاطب متحرّكة، كما كانت تُعرَض على الناس لوحات مرسومة على الأقمشة والبرادي (سمّيت فيما بعد برسوم المقاهي)، تبيِّن واقعة كربلاء، وكانت هذه مقدّمة للعروض المسرحيّة التي أُقيمت فيما بعد، واكتملت، وأصبحت عروضاً تُمثَّل على المسرح.
وآخر تقرير مهمّ عن مراسم محرّم في العصر الصفويّ، كتبه هولنديّ يُدعى كورني بل لابرون، ونشره في العام 1707م، وأشار فيه إلى مضاعفة مراسم العزاء، وزيادة عدد المشاركين، والاهتمام بملابسهم، حيث كانوا يصبغون ملابسهم باللون الأحمر إشارة إلى آثار الجراح والضربات. فالإيرانيّون استخدموا الشَّبيه المتحرّك أو السيّار للتعبير عن حزنهم على الحسين بن علي، وكانت مجموعات تقوم بتمثيل واقعة كربلاء على شاحنات كبيرة تتنقل من قرية إلى أخرى، وكانت الموضوعات ترتبط بقافلة الإمام الحسين وقافلة الحرّ بن يزيد الرياحيّ([261]).
وعلى هذا، فإنّنا نرى في العصر الصفويّ رجالاً يقومون بتمثيل وقائع يوم عاشوراء، ومقتل الحسين على يد قادة يزيد بن معاوية، ولا نجد أيّ إشارة من السيّاح الأوروبيّين الذين زاروا إيران عن مسرح التعزية الذي اكتمل في العصر التالي للصفويّين؛ أي في العصر الزنديّ ومن بعده في العصر القاجاريّ؛ حيث بُنيت تكية دولت من أجل تمثيل وقائع عاشوراء على المسرح. ولا تزال مراسم الشَّبیه تُقام حتی الآن في إيران. ففي قرية كهن آباد التابعة لمدينة غرمسار في محافظة سمنان (شمال شرقيّ طهران) تُقام في شهر محرّم من كلّ عام مراسم الشَّبيه باسم الطفل الرضيع علي الأصغر ابن الإمام الحسين الذي استُشهد يوم عاشوراء، حيث تقوم النسوة بوضع أطفالهنَّ في المهد المُعدّ لهذا الغرض، تأسّياً بطفل الإمام الحسين الذي ذُبح يوم عاشوراء([262]).
زار البريطانيّ الدكتور جيمز موريه([263]) إيران في شهر محرّم سنة 1308هـ/ أغسطس 1890م في عهد ناصر الدين شاه القاجاريّ، ووصف ما شاهده من مراسم التعزية على النحو التالي: «يوم 17 أغسطس، يصادف الأوّل من محرّم سنة 1308هـ، وهو شهر العزاء عند الإيرانيّين، وهم يقيمون مراسم العزاء على أرواح شهداء كربلاء». ويضيف: «دعانا المسؤولون الهنود (المقيمون في إيران) نحن المبعوثين من الحكومة البريطانية إلى إيران، لحضور مراسم عاشوراء. وجلسنا على منصَّة عالية كان عدد كبير من الإيرانيّين والهنود يجلسون حولها. في جانب من المكان كانت غرفة تضمُّ قبر الإمام، وكان يحيط بالغرفة هنود يرتدون زيّاً عسكريا وعليهم ملابس مزركشة وملونة على الطريقة الهندية.كان الجميع أحراراً في الكلام، فقد تحدث العديد منهم عن موت (استشهاد) الإمام الحسين وطرح الخطباء موضوعات شتّى، بعدها صعد خطيب إيراني جميل المحيّا المنبر، وبدأ قراءة نوع من النواح بالمناسبة. وكان الحاضرون يردِّدون العبارة الأخيرة التي كان يتلفظها بصورة جماعية. وعندما وصل إلى القسم الأخير والمحزن من خطبته، دعا الحاضرين إلى اللطم على صدورهم. وكان الناس يلطمون على صدورهم حبّاً واحتراما للحسين بالتنسيق مع النائح» ([264]).
«عندما أنهى النائح نواحه، تمَّ إحضار عَلَم مُغطَّى بقماش من الأبريسم وعليه الريش الملوّن، وكان رجل يحمل العلم الثقيل الوزن ويقوم بتحريكه. وقد انحنى الرجل أمام العلم؛ إحتراما، وقبَّله ورفعه بيديه بينما كان الناس يشجعونه. بعدها صعدالعديد من الرجال على منصَّة صغيرة، وقاموا بقراءة جانب من مصائب الإمام الحسين. وكان الحديث المخصَّص لهذا اليوم ذكر موت ابني السيدة زينب اُخت الحسين اللذين قُتلا على يد شمر بن ذي الجوشن أحد قادة يزيد بن معاوية. كان كلُّ خطيب يقرأ النواح من ورقة في يده، وبصوت عالٍ وبحركات موزونة. وكانت قراءة النواح تثير حزن الناس، وهم يشهقون بالبكاء بصوت عال. وعندما جاء دور اللطم على الصدور أقدم الحاضرون على ذلك بحماس وولع»([265]).
«وخلال مراسم التعزية، ظهر على المسرح رجال يحملون على ظهورهم قِرباً مصنوعة من جلد الثيران مليئة بالماء؛ كرمز لعطش الإمام الحسين في اللحظات الأخيرة من حياته. وكان يحيط بكلِّ سقَّاء خمسة صبيان يدورون حوله»([266]).
ويضيف الدكتور جيمز موريه قائلا: «في الليلة التالية، أي ليلة ويوم الرابع والعشرين من شباط فبراير المصادف للتاسع من محرّم، التقيتُ والسفير، أمينَ الدولة حاجي محمّد حسين خان (أحد رجال البلاط). وقد تجمَّع في منزله الميرزا شفيع والحاجي محمّد حسين خان المروي وفتحعلي خان الشاعر، وعدد من كبار الشخصيات، وعُرضت مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين في ساحة منزله. صعد الخطيب المنبر وقد جلسنا في مكان أمامه، بدأ الخطيب خطبته التي إستغرقت ساعة واحدة، حيث قرأ جانبا من تاريخ استشهاد الإمام الحسين. بعد أن انتهى الخطيب من خطبته، جيء بفرس يرمز إلى فرس الحسين وعلى السرج عمامة الحسين، بعدها جيء بزين العابدين ابن الإمام الحسين، وكان مقيَّداً بالحديد والسلاسل، إلى مجلس يزيد ووراءه أخته. وكان يزيد يجلس مع ثلاثة من أنصاره على أريكة كبيرة. وكان أحد الجالسين يرتدي ملابس أوروبية، ويُظَنُّ أنّه كان سفيرا أوروبيا. كان الجلّاد يعامل الأسرى معاملة سيئة ووحشية، ويرفض طلب النساء بالحفاظ على حياة زين العابدين، وكان يوجِّه إليهن الإهانات بتحريض من يزيد. وعندما أحضروا زين العابدين في مجلس يزيد؛ ليحزُوا رأسه، طلب السفير إلى يزيد أن يعفوَ عنه، ولكنَّ يزيد بدلاً من أن يستجيب لطلب السفير أمر بقتله»([267]).
ويضيف: «كلُّ هذه المشاهد أثارت حزن المشاهدين الذين كانوا يبكون بحرقة، وكانوا يشهقون بالبكاء ويتسابقون في إظهار الجزع والحزن. كان المستشار يبكي باستمرار، وكان أمين الدولة يغطِّي وجهه بيديه ويصرخ عالياً، ومحمّد حسين خان المروي يشهق بالبكاء بصوت عال»([268]).
كانت التعزية في العصر القاجاريّ كالعصر الصفويّ، تتجلّى في مواكب العزاء التي كانت تخرج إلى الشوارع، ويشارك فيها الإيرانيّون، ويبكون وينوحون علی استشهاد الحسين، كما كانوا يلبسون الثياب السوداء؛ حداداً على الحسين ويحملون التوابيت رمزاً لشهداء كربلاء.
مثلما أشرنا سابقاً كانت تُقام في العراق مجالس عزاء خاصّة بالنساء، وتقوم نائحة يُطلَق عليها اسم (الملّاية) بقراءة المراثي للنساء، وهذه المجالس موجودة منذ قرون وحتى وقتنا الحاضر، كما أنَّ هناك مجالس عزاء تُقام للنساء في إيران. حيث كانت تُقام في طهران قبل الحرب العالمية الثانية. وكانت مجالس الشَّبيه تُقام في مناطق في إيران، ومنها جنوب إيران، وكانت النساء تقوم بتمثيل دور النساء في مدينة بوشهر. وكانت قمر السلطنة بنت فتحعلي شاه القاجاري تقيم عروض العزاء لسنوات في البلاط القاجاري. عروض العزاء هذه كانت ترتبط بسيدات مثل فاطمة الزهراء بنت الرسول محمّد|، أو شهربانو بنت يزدجرد زوجة الإمام الحسين([269]).ولا تزال مجالس عزاء النساء تُقام حالياً في المدن الإيرانيّة تشارك فيها النساء، ويكون الخطيب رجلا يتحدَّث عن واقعة عاشوراء، وتقرأ امرأة تُسمَّى الملّاية أشعاراً في رثاء الحسين بالفارسيّة، وتقوم النساء بترديد الأشعار، بعدها تقوم النساء باللطم على صدورهنَّ، ويُوزَّع الشاي والحلوى والفواكه والطعام على المشاركات.
يُطلَق اسم الحسينيّة في إيران على المكان الذي تُقام فيه مجالس العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين× في شهري محرّم وصفر([270]). كما يُطلَق اسم الحسينيّة على أماكن إقامة العزاء في العراق ولبنان، ويُطلق اسم المأتم على أماكن اقامة العزاء في كلٍّ من البحرين وسلطنة عمان. وفي بعض مناطق آسيا الوسطى يُطلَق على الحسينيّات التي يبنيها الشيعة اسم (مسجد الشيعة)، وفي مناطق الهند المختلفة تُسمَّى التكية والحسينيّة بأسماء مختلفة مثل: عزاخانه، إمام بارا وإمام باره، تعزيه خانه، وعاشورا خانه، وتابوت خانه، وجبوتره وجوك إمام صاحب([271]). ويُطلَق على الحسينيّة في أفغانستان اسم منبر([272]).
ويعود بناء الحسينيّات في إيران إلى العصر الصفويّ، ولكن هناك حسينيات بُنيت قبل العصر الصفويّ؛ أي في العصر الإيلخاني (654 ـ 750هـ). ومنذ العصر الصفويّ الذي كان الاهتمام منصبّاً على إقامة مجالس العزاء في شهر محرّم، بُنيت حسينيات كثيرة في مختلف مناطق إيران، وخُصِّصت المحلَّات والساحات في المدن والقرى لتتخذ تكايا وحسينيات تُقام فيها مجالس العزاء([273]).
وتكثر الحسينيّات في العصر الحاضر في طهران والمدن الإيرانيّة، ولكلِّ مجموعة أو مهنة حسينية يقيمون فيها مراسم العزاء في شهري محرّم وصفر، وبمناسبات مختلفة، وتختلف مساحة الحسينيّات طبقا لإمكانيّات مشيِّديها، وقد نقلت لنا الكتب تفصيلات عن حسينية مشير في مدينة شيراز التي بُنيت في عهد ناصر الدين شاه القاجاري في العام 1303هـ/1847م. وزُخرف إيوانها الشمالي بالقاشاني ذي السبعة ألوان، وقام الرسّام المعروف آغا بزرك برسم لوحة كبيرة عن معركة عاشوراء واستشهاد الحسين بن علي وأصحابه على الإيوان الشمالي من الحسينيّة بناءً على طلب صاحب الحسينيّة الحاج ميرزا ابو الحسن خان مشير الملك([274]).
والحسينيّات تبنى عادة من جانب المواطنين وليست من جانب الحكومة، إذ يخصص المواطنون أموالا لبناء الحسينيّات والصرف عليها. كما تقوم جماعات تعمل في مهنة خاصة أو تنتمي إلى مدينة من المدن ببناء حسينية لها في العاصمة أو المدن الكبرى وتطلق عليها اسم تلك الجماعة أوأصحاب المهنة.
أسواق إيران، مراكز لإقامة مجالس العزاء
لم تكن الأسواق في مختلف أنحاء إيران في القرون الماضية مكاناً للتجارة والبيع والشراء فقط، بل كانت مركزا للأنشطة الاجتماعيّة والثقافية والدينية والسياسيّة. فكانت الأسواق مكاناًً لتبادل آخر المعلومات والأخبار، ومنها كانت تُنقل الأخبار إلى الأماكن الأخرى؛ نظراً لارتياد مختلف أبناء الشعب عليها. وكان هناك في القرن الماضي منادٍ ـ وهو موظَّف حكوميّ ـ يقوم بإبلاغ المواطنين في الأسواق بقرارات الحكومة عندما لم تكن هناك إذاعة وتلفزيون([275]). وكانت تُقام في الأسواق التجارية في العاصمة طهران والمدن الإيرانيّة مراسم ومجالس العزاء بمناسبة استشهاد الإمام الحسين في شهر محرّم، وكان لكلِّ صِنف ومهنة موكب عزاء يشارك فيه أعضاء من هذا الصنف([276]).
كان تجّار السوق في المدن الإيرانيّة يدعمون علماء الدين والمراجع بدفع أموال الخمس والزكاة اليهم، حيث كان العلماء يحصلون على مرتَّباتهم ومرتَّبات طلبة العلوم الدينية من أموال الخمس والزكاة؛ ولذلك فان علماء الدين الشيعة في إيران كانوا مستقلين عن الحكومة، وغير مرتبطين بها، وكانوا يتخذون قراراتهم بصورة مستقلة، كما كانوا يتخذون مواقف معارضة للحكومة اذا ما اتخذت قرارات مخالفة للقيم الدينية([277]).
كما كانت الأسواق التجارية مكاناً للأنشطة السياسيّة؛ وقام الكسبة والتجار في إيران بدور كبير في انتصار الثورة الإسلاميّة في العام 1979م، بعد قيامهم بالإضراب العام وإغلاق الأسواق؛ احتجاجاً على حكومة الشاه محمّد رضا بهلوي لقمعه الحركة الثورية في إيران.
طقوس العزاء الحسينيّ في العصر الحديث
تواصلت طقوس العزاء في ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي في إيران إلي العصر الحديث كما في الماضي، ولكن اُدخِلت عليها تغييرات عديدة؛ بسبب التطورات السياسيّة التي طرأت في إيران ومنها قيام الثورة الإسلاميّة في العام 1979م.
وكانت هذه الطقوس تُمارَس قبل الثورة بكلِّ قوة، ويقوم بعض العلماء والوعّاظ بتشجيع هذه الطقوس على أنَّها شعائر إسلامية تعزِّز الروح الإسلاميّة للمجتمع الإيرانيّ مقابل ما كانوا يعدّونه محاولات الحكومة الملكية السابقة لإضعاف أُسس الدين الإسلاميّ، وإدخال المجتمع في متاهات؛ ليبتعد عن الدين ويقترب من مظاهر الحضارة الأوروبية والإمريكية.
وبعد انتصار الثورة في إيران، شجَّع علماء الدين وعلى رأسهم الإمام الخميني المواطنين على تعظيم شعائر الله؛ مشيرين إلى الآية الكريمة (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) ([278]). وأطلق الإمام الخميني مقولته المشهورة تأييدا لاستمرار العزاء الحسينيّ: «كلُّ ما لدينا من مكاسب هو من بركة عزاء الإمام الحسين في شهري محرّم وصفر. وإن محرّم وصفر قد أحیيا الإسلام»([279]).
وقال أيضا: «ليعلم شعبنا قيمة وأهمية هذه المجالس (مجالس العزاء) التي أبقت الشعوب حيَّة في أيام عاشوراء، إنني آمل أن تُقام هذه المجالس بشكل أفضل وعلى نطاق أوسع، وإنَّ للجميع بدءً من الخطباء وإنتهاءً بقرّاء المراثي والقصائد دوراً وتأثيراً في ذلك»([280]).
ولكن العديد من علماء الدين كانوا يحذِّرون الإيرانيّين من محاولاتٍ لحرف عزاء الإمام الحسين وإدخال طقوس جديدة تبعد المجتمع الإيرانيّ من العزاء الحقيقي. واتّهم أحد رجال الدين الإيرانيّين الولايات المتحدة بتحريف ثقافة عاشوراء ومواجهة التراث الثقافي الإيرانيّ([281])، بقوله: «إنّ ما يحقّق فلسفة العزاء هو مكافحة الجهل المترسّخ في المجتمع الإسلاميّ، وتقديم تحليل واقعيّ عن واقعة عاشوراء، وعدم استغلال مشاعر الناس تجاه أهل البيت، وشرح أهداف ثورة الحسين بدلاً من طرح قضايا جانبيّة لا تمتّ بصلة إلى ثورة الحسين»([282]).
ويعتقد الشيخ مرتضى مطهّري أنّ إحدى آفات المراثي والتعازي في عاشوراء اختلاق الكذب في ما يتعلّق بطقوس التعزية، وإضافة قصص وأساطير إلى أحداث عاشوراء لا لسبب وجيه، بل بسبب إضفاء روح الحماسة على هذه الطقوس([283]).
ویری الشيخ محمّد محمدي ری شهری، بأنَّ قراءة العزاء والنياحة أصبحت اليوم حرفة ومهنة لبعض الأشخاص يتكسبون من طريقها، وهؤلاء ـ من أجل أن يطرحوا قضايا جديدة تجلب انتباه المستمعين، وتخرج العزاء من الرتابة ـ يحاولون طرح قصص جديدة ومثيرة ومختلقة عن واقعة عاشوراء، وحيث أن مصائب عاشوراء هي محدودة؛ لذا فإنَّهم يحاولون إختلاق أحداث ومصائب جديدة، لا تخدم العزاء، بل تزيدها وَهْنا وضعفا. كما أنَّ هناك أهدافاً يعمل من أجل تحقيقها بعض الأشخاص، ومنها كسب فوائد مادية وشهرة دنيوية([284]).
ومن المواضيع التي أخذت الحكومة الإيرانيّة بعد الثورة على عاتقها محاربة ما أُدخل على العزاء من ممارسات واستخدام أدوات وآلات عُدّت مخالفة للتعزية وطقوسها، ومنها استخدام آلات موسيقيّة حديثة، واستعمال أنغام والحان مأخوذة من الأغاني المذاعة، وكذلك تشبّه الرجال بالنساء، ومنها أيضاً التطبير حيث منعت الحكومة الإيرانيّة كلّ هذا على أساس أنَّه بدع أُدخلت إلى طقوس العزاء. جاء منع التطبير في إيران والذي كان متعارفاً في البلدان العربيّة والإسلاميّة بعد أن أصدر المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي فتوى منع بموجبها ممارسة التطبير في أنحاء إيران. وجاء في الفتوى ما يلي:
«التطبير هو من الممارسات المخالفة للشريعة، لا يمكن السكوت تجاه هذه الممارسة الخاطئة. إنّ قيامَ عددٍ من الأشخاص برفع قامة بأيديهم ويضربون بها رؤوسهم وينزفون دماً فهذا عمل خاطئ. كيف يمكن لهذه الممارسة أن تُعدّ تعزية. الضرب باليد على الرأس يُعدّ عزاء.
أنتم ترون بأنّه إذا ما أصاب الشخص مصيبة فإنّه يضرب صدره ورأسه بيديه جزعاً من هذه المصيبة، ولكن هل رأيتم شخصاً يضرب بآلة حادّة رأسه وينزف دماً، بسبب مصيبة ألمّت به أو إذا فقد عزيزاً عليه؟ هل هذه تعدّ عزاء؟ التطبير يُعدُّ عادة مختلقة، ولا ترتبط بالدين، ولا شكّ أنّ الله لا يرضى عمّن يقوم بهذه الممارسة. فالعلماء السابقون لم يتمكّنوا من منع التطبير، ولم يتمكّنوا من التصريح بحرمته وأن يقولوا أنّه خلاف للشريعة».
ويضيف: «فاليوم علينا أن نظهر الإسلام كدين سماويّ، لا أن نطرحه كدين خرافيّ يمارس أتباعه الخرافة باسم الحسين بن عليّ، وباسم الإمام عليّ. فالمسلمون وغير المسلمين يجب أن يأخذوا انطباعاً حسناً عن المسلمين، لا أن يرونهم يمارسون عادات خاطئة وممارسات تُعدّ بدعة»([285]).
فتوى آية الله السيد علي خامنئي قائد الجمهورية الإسلامية في إيران كانت الخطوة الأولى لمنع التطبير في إيران، ولم نسمع منذ صدور الفتوى عن قيام أشخاص بممارسة التطبير علناً، وأمام مرأى الناس في إيران، على الرغم من عدم منعه في العراق ولبنان.
درج الإيرانيّون على حمل المشاعل والتوابيت في مواكب العزاء أيام العشرة الأولى من شهر محرّم. فالمشاعل تُحمل عادة مع مواكب العزاء في الليل من أجل إضاءة مسار الموكب والمشاركين فيه؛ لأنَّ الشوارع والساحات العامّة في الماضي السحيق معتمَة بسبب عدم وجود الكهرباء. وكان الناس يحملون مع المواكب مشاعل كبيرة يضعون عليها مصابيح تُضاء بالنفط الأبيض، ولكن عندما وصلت الكهرباء إلى البلدان العربيّة والإسلاميّة أخذت المواكب تحمل معها المشاعل الكبيرة المزوَّدة بالمصابيح الكهربائيّة.
ولا زالت مواكب العزاء في إيران تحمل معها مشاعل صغيرة مزوّدة بمصابيح كهربائيّة، أو تحمل مع مواكب العزاء مصابيح كهربائيّة موضوعة على عربات أو سيّارات مزوّدة ببطاريّات كبيرة تولّد الكهرباء؛ لإنارة المصابيح، وكذلك تحمل مكبّرات صوت مع المواكب، ويقرأ النائح أشعاراً في رثاء الحسين مستخدماً مكبّر الصوت؛ ليسمعه المشاركون في الموكب أو المستمعين. ولا زالت مشاعل كبيرة تُحمل مع مواكب العزاء في العراق، يحملها رجال أقوياء، ويجوبون بها الشوارع والساحات العامّة.
منذ العصر الصفويّ، اعتاد الإيرانيّون علی حمل التوابيت والهوادج، وتسيير العربات عند خروج مواكب العزاء أو الشَّبيه، تشبُّهاً بأهل البيت وأعدائهم من قادة وجنود جيش بني أميّة. كان الإيرانيّون كما هو الحال في العراق يخرجون الشَّبيه إلى الشوارع والساحات العامّة ليمثّلوا أدوار الحسين وأصحابه وأهل بيته في مواجهتهم لقوّات جيش بني أميّة. وكانت تُدار معارك في الساحات العامّة بين مَن يمثّلون جيش الحسين ومن يمثّلون جيش يزيد بن معاوية. وكانت تُحمل مع مواكب العزاء توابيت ترمز إلى استشهاد الحسين وأصحابه وأهل بيته. لا تزال بعض مواكب العزاء التي تخرج في إيران أيام شهر محرّم، تحمل معها توابيت تمثّل جنازة الحسين بن علي والشهداء من أبنائه وأهل بيته وأصحابه. وتُصنع التوابيت على أنواع، منها المستطيل كما هو التابوت الذي يُحمل بواسطته الميّت إلى قبره، ومنها المكعّب، ومنها ما هو على شكل الهودج والمحمل، وهناك تابوت يسمّى في إيران بـ(النخل) أي (تابوت الإمام الحسين) (بسبب استخدام أخشاب النخيل في صنعه) وهو غرفة خشبية مختلفة الأحجام، ومنها الكبير الذي يبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار وعرضه خمسة أمتار، لوزي الشكل، وأكبر نخل موجود في مدينة يزد (وسط إيران) ويُسمّى (نخل ميرچخماق). وفي شهر محرّم من كلّ عام يقوم أهالي المدينة بوضع السواد عليه، وتزيينه بالمرايا والأعلام والأقمشة الفاخرة، وعند ظهر عاشوراء من کلّ عام يتوجّه أهالي يزد إلى الساحة العامّة المسمّاة بساحة (ميرچخماق) من أجل المشارکة في عزاء الحسین ومشاهدة حمل النخل. ويقوم عشرات الشبّان الأقوياء بحمل النخل على أكتافهم ـ والذي يقف فوقه عشرون شاباً ـ ويدورون به في الساحة مرّات عديدة، ويردّد المشاركون في مراسم العزاء (يا حسين، يا حسين) وتسمّى هذه المراسم بـ(نخل گردانی) [النخل الدوّار]([286]).
فالأشخاص الذين يقفون على النخل يقرأون أشعار الرثاء، ولا سيّما أشعار الشاعر الإيرانيّ محتشم الكاشانيّ (من شعراء العصر الصفويّ) المختصّة باستشهاد الحسين، بينما يضرب العديد منهم على الطبل والصّنج.
فتزيين النخل وحمله له طقوسه الخاصّة التي تُقام منذ مئات السنين، وهناك أشخاص وعوائل تتولّى تزيين النخل بالأقمشة الملوّنة الفاخرة والثمينة والمصابيح والورود والمرايا، ويعلّقون عليها السيوف والخناجر والخوذ والأعلام، وصور أئمّة أهل البيت. ولا يزال حمل النخل متداولاً في بعض المدن الإيرانيّة خلال شهر محرم([287]) فهذا الطقس خاصّ بإيران.
وفي العصور السابقة كانت كلّ مدينة إيرانية تصنع تابوتاً يُحمل في عاشوراء له اسمه الخاصّ. فكما أشرنا في السطور السابقة أنّ التابوت الذي يُحمل في مدينة يزد يُسمّى (النخل)، ولكن هناك توابيت أخرى تُصنع من الخشب وتُسمّى بأسماء أخرى. ففي محافظة خوزستان التي تقع جنوبيّ إيران يصنع أهالي كلّ مدينة من مدن المحافظة تابوتاً يختصّ بمدينتهم ويسمّى باسم (شيدونه). وفي مدينة قم المقدسة كان أهالي المدينة يصنعون تابوتاً يسمّونه (دغدغه)، يحملونه في عاشوراء بعد تزيينه بالشموع والأقمشة والمصابيح. وعندما كان أحد العلماء والمراجع يفارق الحياة كان يوضع جثمانه في هذا التابوت ويشيّع إلى مثواه الأخير([288]).
وفي مدينة كاشان الإيرانيّة كان هناك تابوت سداسيّ الأضلاع يسمّى (شش گوشه) يُحمل في شهر محرّم مع مواكب العزاء، وكان التابوت يُزيَّن بالأقمشة، وتُعلّق عليه أشعار في رثاء الحسين.
كما كان في كاشان تابوتان آخران صُنعا لموكب محلّة بانخل، يشبه أحدهما ضريح الإمام الحسين، والآخر ضريح أخيه العبّاس، ويُسمّى الأوّل (شط الفرات) والثاني (نهر علقمة)([289]).
وتتقدّم مواکب العزاء في إيران أعلام ورايات ملوّنة منها الأسود والأخضر والأحمر، كما أنّ بعض المواكب يحمل رايات كبيرة مصنوعة من النحاس وتسمّى (علامت) بالفارسيّة، و(شاه سلام) أي سلام عليك أيّها الملك، ويقصد به الحسين ابن علي. والراية مصنوعة من جسم حديدي على شكل صليب، عرضه يبدأ من مترين إلى عشرة أمتار، وتُوضع عليه أوراق نحاسيّة هندسيّة الشكل تتحرّك إلى الأمام والخلف، وتُزيَّن الراية بنقوش نباتيّة وآيات قرآنيّة، وزخرفة بطريقة التخريم كما تُزيَّن بالأقمشة الفاخرة الملوّنة، وتُرفع الراية أمام الموكب ويحملها شابّ قويّ أو شبان أقوياء إذا كان كبيراً. كما تُوضع الراية أمام مجالس العزاء ومقرّات مواكب العزاء. وكانت هذه الرايات تُحمل سابقاً مع مواكب العزاء في العراق قبل مجيء حزب البعث إلى السلطة، الذي منع حمل هذه الرايات، وقد شاهدتُ في أثناء زيارتي للعراق اثنين من هذه الرايات في متحف الإمام الحسين في العتبة الحسينيّة في كربلاء، ويرجع تاريخ صناعة إحداها إلى العام 1281هـ/1860م، وتاریخ صناعة الراية الثانية يعود إلى القرن التاسع الهجريّ.
ويوجد في متحف الإمام الحسين أيضاً رمّانة من النحاس (كروية الشكل) تُوضع فوق قمّة الراية، وكفّ يدٍ نحاسيّة ترمز إلى كفّ العبّاس بن علي التي قُطعت يوم عاشوراء، وهذه الكفّ التي تُسمّى بالفارسيّة (دست حضرت عبّاس) [کفّ العبّاس] تُوضع فوق الرايات التي تُحمَل مع مواكب العزاء في إيران.
عُرف الخطيب في إيران باسم (روضه خوان) [قارئ الروضة أو العزاء] أي إنّهم كانوا يقرأون مقاطع من كتاب (روضة الشهداء) للخطيب الإيرانيّ المعروف ملا حسين واعظ كاشفي المتوفى في العام 910 للهجرة. والكتاب يضمّ بين دفّتيه تفاصيل عن واقعة كربلاء، ويُعدّ الكتاب من كتب المقاتل، أي شرح وقائع كربلاء وما جرى للحسين من حوادث يوم عاشوراء.
ومنذ العصر الصفويّ، أصبح مَن له صوت جهوريّ يمتهن الخطابة، ويسمّى (روضه خوان) أي يصعد المنبر ويقرأ ما يحفظه من (مأساة كربلاء)، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الخطابة والوعظ مهنة لكثير من الأشخاص([290]).
في ما مضى، كان هنالك شخص يُطلق عليه اسم ( بامنبري) (مساعد الخطيب) والمعنی الحرفيّ للعبارة رِجل المنبر، كان يقف إلى جانب المنبر، ويقرأ أشعاراً في مدح أهل البيت قبل أن يعتلي الخطيب المنبر. ومساعد الخطيب كان من واجبه أن يهيّئ الأجواء حتى يصل الخطيب ويعتلي المنبر. وهذا الشخص كان يحفظ أشعاراً في مدح الحسين وأهل بيت رسول الله ورثائهم، ووصف واقعة كربلاء، وكان مساعد الخطيب عادةً، طفلاً أو يافعاً([291]).
ظهر في إيران خلال العقود الماضية رسّامون، كانوا يرسمون وقائع يوم عاشوراء على الجدران والستائر والأقمشة، وكانوا ينشرونها في مناسبات خاصّة أيام شهر محرّم. وسُمِّيت رسوم الرسّامين باسم (رسوم المقاهي) إذ كان الرسّامون يتخذون من المقاهي أماكن لعملهم.
ظهرت رسوم للأئمّة من أهل البيت ولا سيّما الإمام عليّ والحسين والعبّاس في العراق وبشكل خاصّ في مدينة كربلاء في القرن الماضي، وكان رسّامون إيرانيّون سكنوا كربلاء، ورسموا صور الأئمّة على القماش كما رسموا وقائع عاشوراء([292]).
نقلت لنا كتب التاريخ نماذج من الرسوم الحائطيّة القديمة التي وصلتنا من مختلف المدن الإيرانيّة. وسنشرح بالتفصيل رسوم المقاهي في نهاية هذا الفصل.
السقّاؤون هم طبقة من الأشخاص كانوا يحملون قِرَبَ الماء، ويقدّمون الماء إلى الناس خلال مراسم العزاء في أيام شهر محرّم ويوم عاشوراء في كلّ عام. وكان السقاؤون يقومون بعملهم هذا من أجل الحصول على ثواب الآخرة. وكانوا يردّدون العبارة التالية: «اِشرب الماء واُذكرْ عطش الحسين، اِشرب الماء واِلعنْ يزيد». كان السقّاؤون يقدّمون الماء للناس في أثناء مراسم العزاء التي كانت تُقام في المدن العراقيّة ولا سيّما في كربلاء في الستينات والسبعينات من القرن الماضي([293]).
أُقيمت في إيران والعراق في العقود الماضية أماكن خاصّة لتسبيل الماء، هذه الأماكن شُيّدت في الشوارع والأماكن العامّة، وكان يقدّم فيها الماء البارد إلى المواطنين في فصل الصيف، ولا زالت هذه العادة موجودة في إيران، وفي العراق وجنوبيّ لبنان؛ إذ يُقدّم الماء إلى المارّة في الشوارع؛ تقرّباً إلى الله وأهل البيت، وتُخصّص هذه الأماكن لتسبيل الماء وتُسمّى في إيران بـ(السقَّاخانه) أي سقي الماء([294])، وتُكتب على هذه الأماكن أشعار تذكّر الناس بعطش الحسين يوم عاشوراء، ومن هذه الأشعار التي قِيلت على لسان الحسين بن علي:
|
شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني |
وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين([295]).
ویُطلَق عليه في العراق كلمة السبيلخانه، وفي البلاد العربيّة سبيل، أو سبيل ماء. وينقل الشيخ الصدوق في أماليه عن الإمام جعفر الصادق قوله: «ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين، ولعن قاتله إلّا كُتِب له مائة ألف حسنة، وحُطّ عنه مائة ألف سيئة»([296]).
بدأ الرسّامون الإيرانيّون في العصر الصفويّ رسم صور الأئمّة، وتصوير القصص الدينيّة وبطولات شهداء كربلاء على الجدران، كما رسموا وجوه المعصومين، وواقعة كربلاء، واستشهاد الحسين وأصحابه في كربلاء، على جدران الأواوين والمراقد والمزارات والأماكن المقدّسة والتكايا وأماكن تسبيل الماء. وكان لكتاب روضة الشهداء من تأليف الملا حسين واعظ كاشفي السبزواريّ الأثر الكبير في تصوير وقائع يوم عاشوراء، حيث أضاف الرسّامون بريشتهم صوراً من وحي هذا الكتاب، وجسّدوا مظاهر الجمال والقبح والقوّة والضعف والطهارة والخساسة.
على الرغم ممّا نُقل عن الرسول| من تحريم الرسم لذوات الأرواح، فقد رسم الرسّامون الإيرانيّون صور الأئمّة ووقائع عاشوراء على الجدران والأقمشة والبرادي، ولا زالت صور الأئمّة تُحمَل مع مواكب العزاء في العراق والبلدان العربيّة. ومنعت الحكومة الإيرانيّة أخيراً رسم صور الأئمّة وحملها مع مواكب العزاء في أيام محرّم وصفر.
ويعتقد الكاتب صموئيل بيترسون «بأنَّ الأفكار المتطرفة في بداية ظهور الإسلام كانت تمنع الرسم وتعدّه إهانة للمقدَّسات. وعلى الرغم من وجود مثل هذا المنع، فإنَّ رسوماً تمثِّل وجوهاً إنسانية رُسِمت على جدران القصور الأوائل». ولا يستبعد بيترسون أن تكون هذه الصور للنبي محمّد وأهل بيته. ويضيف بأنَّ هذه الرسوم نُقشت على جدران بعض القصور، وتمَّ الإحتفاظ بصور اعتُبرت نفيسة وكانت موجودة عند بعض الأشخاص([297]).
ويرى بيترسون أنَّ مسرح التعزية كان له تأثير في الفنون التصويريّة ويعدّه أحد أهمّ التطوّرات في تاريخ الفنّ الإسلاميّ. ويضيف أنّ الرسم الذي ظهر في القرن التاسع عشر على يد الرسّامين الإيرانيّين ارتبط بالموضوعات الدينية وحظي باهتمام أغلب الإيرانيّين. وقد عُرف هذا الرسم عند عامة الناس برسوم المقاهي، وهو الرسم المخَصَّص لاستشهاد الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه. ويرى بيترسون أنَّه من الأجدر أن تُسمَّى هذه الرسوم برسوم كربلاء([298]). وقد وصلتنا صور ووجوه الشخصيات الدينية مرسومة على جدران بعض مقابر أبناء الأئمّة، ومزارات الشخصيّات الدينيّة في المدن والقرى في إيران. وخير مثال على ذلك مجموعة الرسوم الموجودة على جدران مرقد زيد، أحد أحفاد علي بن الحسين بن أبي طالب في مدينة إصفهان والتي وصلتنا من العهد الصفويّ([299]).
فالرسوم التي نُقِشت على جدران مرقد زيد في إصفهان تشير إلى أنَّها رُسِمت في القرن الحادي عشر للهجرة، أي بالتزامن مع عصر سليمان الصفويّ، وذلك خلال ترميم بناء المرقد. ولا يُعرَف اسم أو أسماء الرسّامين الذين رسموا الصور. في حين أنّ أسماء الرسّامين الذين زخرفوا جدران قصور الشاه عبّاس معروفة ومدوَّنة.
فالجداريّة المرسومة على جدار مقبرة زيد تصوّر واقعة كربلاء وصورة الإمام الحسين، وهو يمتطي جواده، وقد غطّى الرسّام وجه الحسين بهالة من نور. كما أنّ الجدارية تضمّ صورة فَرَس الإمام الحسين (ذو الجناح) وقد أصابته السهام. ويقف أسد إلى جانب فرس الإمام الحسين، كما يُشاهد السلطان قيس ملك الهند وهو على ظهر جواده والى جانبه وزيره. وهذه الجداريّة تشرح قصّة السلطان قيس ملك الهند عندما هاجمه أسد وهو في الصيد، فتضرّع إلي الإمام الحسين وطلب منه أن ينقذه من الأسد([300]).
وهناك جداريّة أخرى تظهر صورة الإمام الحسين، وهو يحتضن جسد ابنه عليّ الأكبر بعد أن أصابته سهام الأعداء، ووقع رمحه وترسه على الأرض. وفي جانب من الجداريّة تشاهَد نساء الحسين، وقد رفعنَ أيديهنَّ إلى السماء، وفي زاوية أخرى من الجداريّة يُشاهد عدد من الأشقياء من جند يزيد بن معاوية، وقد رفعوا رؤوس الشهداء على الرماح. كما يُشاهد عدد من الملائكة في الصورة.
في صورة أخرى منقوشة على جدران مرقد زيد يُشاهد العبّاس بن علي بن أبي طالب وهو يمتطي جواده، وقد رُسمت هالة من نور حول وجهه، وهو يتقدّم نحو نهر الفرات، كما تُشاهد في الجداريّة ثلاث نساء من أهل بيت الحسين، يقدّمنَ قربة إليه؛ ليملأها ماءً. وإنّ عدّة نساء يقفنَ في جانب من الجداريّة، ويلطمنَ على رؤوسهنَّ، وهنَّ واقفات خارج الخيم. في جداريّة أخرى، تُشاهد ساحة القتال وقد استُشهد عليّ الأكبر ابن الإمام الحسين والقاسم وعبد الله ابنا الإمام الحسن بن علي في كربلاء([301]).
وهناك نماذج لرسوم نُقشت على جدران (تكية معاون الملك) في مدينة كرمانشاه (غربي إيران)، ويدَّعِي صموئيل بيترسون بأنّ الرسوم ارتبطت بقصّة النبي يوسف× وصوّرت قصّة يوسف كما جاء في القرآن الكريم. ويتساءل بيترسون لماذا صُوّرت قصّة يوسف في تكية مخصَّصة لعرض واقعة كربلاء؟ ويجيب بالقول إنّ يوسف وأباه حزنا على الحسين، وقالا كلاماً فيه رسالة تقول: «إنّ ألف مثلي ومثل يوسف فداء للحسين وألف يوسف يساوي تراب أقدام الحسين. تعال يا جبرائيل، أرني كربلاء، من أجل الله»([302]).
ولم يذكر بيترسون على ماذا استند في نقل روايته هذه. لكنّه ينقل أيضاً مشاهد لصورة رُسمت على جدران تكية كرمانشاه (إلى الشمال الغربيّ من إيران) تمثّل عرس النبي سليمان× وبلقيس، ويقول تعليقاً على الصورة: «إنّ النبي سليمان قادر على مشاهدة أحداث الماضي والحاضر، ويحزن لشهداء كربلاء، ويوقف عرسه، حتى يعلن عن الاحتفال بعرس القاسم بن الإمام الحسن بن علي وفاطمة بنت الحسين، ولكنَّ العريس القاسم يعود من ساحة القتال مضرّجاً بدمه وهو يحتضر»([303]).
الرسم المنقوش على تكية معاون الملك في كرمانشاه يظهر النبي سليمان وهو جالس على العرش، ويحيط به مستشاروه من الجنّ وممثّلو الحيوانات، ومعهم العنقاء الأسطوريّة والهدهد والمبعوث الخاصّ للنبي سليمان يقفون إلى جانبيه. وهو يرى أنّ هذه الحيوانات الأسطوريّة والحيوانات الكبرى مثل الفيل والأسد لا يمكن أن تكون قد صُوّرت بالإلهام من المكان أي مدينة كرمانشاه، بل ويرجِّح أن يكون الرسّامون قد استلهموا الصور من صور الحيوانات الكبيرة المعروضة في بلاطات الملوك([304]).
أمّا أهمُّ رسم نُقش على تكية كرمانشاه، فهو الرسم المختصّ بواقعة كربلاء، حيث رُسم على غرار عروض التعزية، ويبيّن الرسم أهل بيت الحسين×، وهم يقفون أسرى في بلاط يزيد بن معاوية في دمشق. وقد غطّى الرسّامون وجوه أهل بيت الحسين بالنقاب وهالة من النور. وفي الصورة يُشاهَد يزيد بن معاوية في أعلى الصورة، يجلس على العرش الذي رسمه الرسّامون على غرار عرش الطاووس [أي عرش الشاه محمّد رضا بهلوي]. ويجلس على الكرسي المخصَّص للضيوف على يسار يزيد سفير (أجنبي) و(المستشار الخاص)، والكرسي يشبه الكرسي الذي كان يوضع في بلاط ملوك العصر القاجاريّ. ويقف في مجلس يزيد الإمام عليّ بن الحسين زين العابدين، وزينب أخت الإمام الحسين وبجوارهما أطفال صغار منهم: سكينة وزبيدة وفاطمة أرملة الشهيد القاسم ابن الحسن المجتبى([305]).
وفي العصر الصفويّ اشتهر عدد من الرسّامين الذين رسموا صور الملوك والأمراء وأبنائهم وموظّفي البلاط، وصور الحيوانات والطبيعة والمنمنمات ولا زالت هذه الرسوم موجودة في القصور التي بقيت حتى الآن في مدينة إصفهان يوم كانت عاصمة الصفويّين([306]).
رضا عبّاسي أشهر رسّام جداريات في العصر الصفويّ
اشتهر الرسّام الإيرانيّ رضا عبّاسي (المولود في العام ۹۷٤هـ والمتوفّى في العام ۱۰٤٤هـ). برسم اللوحات الجداريّة الضخمة، وإدخال أساليب الرسم الحديثة في أعماله، وأكثر تلاميذه ومعجبيه تعلّموا الرسم على يديه، واكتسبوا من إبداعه الفنّيّ وأصالة عمله الذي انفرد به. ترعرع هذا الرسّام في حضن والدٍ كان هو الآخر رسّاماً وفناناً بارعاً هو( علي أصغر الكاشانيّ) الذي كان مقرَّباً من بلاط الشاه (طهماسب الصفويّ)، فكما تعلّم رضا فنّ الرسم من والده، تأثّر أيضاً بأعمال الفنّان الشيخ محمّد النقّاش.
لقد عاش الرسّام رضا عبّاسي العصر الذهبيّ للفنّ زمن الشاه عبّاس الكبير (966 ـ 1038هـ/1588 ـ 1629م) في حقبة نشطت فيها الحركة التجاريّة والسياسيّة لا سيّما في مدينة إصفهان عندما كانت عاصمة الحكم الصفويّ؛ حيث زاد إقبال الدول الأوروبيّة والإمبراطوريّات الآسيويّة ـ ومنها إمبراطوريّة غوركاني في الهند في مرحلة الحاكم جهانغير شاه وسلاطين العثمانيّين ـ على إيران، والتفاعل مع حركة الفنّ المتنوّع المنتعش فيها، وبرز من بين الأوروبيّين الرسم الإيطاليّ وأنواع الرسم الهنديّ والعثمانيّ خاصّة في (عصر النهضة)، فوصل التنافس الفنّيّ أوجَه، خاصّة رسوم ونقوش اللوحات الجداريّة، وكثر إثر ذلك الرسم والرسّامون.
في العام 1386 للهجرة أُسِّس متحف في طهران يحمل اسم الرسّام رضا عبّاسي، يضمّ لوحات لثلاث مراحل قبل الإسلام، وصدر الإسلام، وآثار الفنّ الإيرانيّ المعاصر، ويضمّ المتحف آثاراً ورسوماً كلاسيكيّة فارسيّة وأجنبيّة([307]).
ألهمت أحداث كربلاء ومقتل الحسين بن عليّ× العديدَ من الفنّانين والرسّامين الإيرانيّين؛ ليرسموا لوحات علی الجدران، أو على القماش والورق والزجاج عن هذه الواقعة، ويصوّروا بطولات الحسين وأصحابه في معركتهم في مواجهة جيش بني أميّة. عُرفت هذه الرسوم بـ(رسوم المقاهي)، لأنَّ أصحابها كانوا يتخذون المقاهي الشعبيّة مقرّاً لهم لرسم لوحات عن واقعة كربلاء. فرسوم المقاهي الشعبيّة أو ما يُسمّى بالفارسيّة (نقاشى قهوه خانه اى) هي رسوم تروي الأحداث الدينيّة، ولا سيّما أحداث كربلاء والحروب والبطولات التي سطّرها الحسين بن عليّ وأهل بيته وأصحابه في مواجهة جيش يزيد. ويختلف الكتّاب حول زمان بداية هذه الرسوم، «فمنهم من يُرجعه إلى ثلاثة قرون خلت، بينما يرى آخرون بأنّ هذه الرسوم بدأت في العصر الصفويّ (907 ـ 1135هـ/1501 ـ 1722م) عندما أُعلن أن المذهب الشيعيّ هو المذهب الرسميّ لإيران»([308]). ويقول العارفون بهذا النوع من الرسم الإيرانيّ بأنّ الرسّامين كانوا يرسمون لوحاتهم عن واقعة عاشوراء في المقاهي «لأنّها كانت المكان المفضّل للرسّامين، حيث كان يتجمّع الناس فيها بعد يوم من العمل، يشربون الشاي ويستمعون إلى رجال يحفظون الأشعار الحماسيّة والمراثي الحسينيّة، ويشيرون إلى الرسومات التي كانت تُعرَض على روّاد المقاهي كما كانت تُعرض هذه الرسوم في المساجد والحسينيّات والتكايا»([309]).
ويرى الكاتب الإيرانيّ علي بلوكباشي أنَّ رسوم المقاهي أو رسوم الأئمّة من أهل البيت وصلتنا من العصر البويهيّ في القرن الرابع الهجريّ. ويضيف في كتابه (تعزيه خواني)[قراءة التعزية] نقلاً عن رسالة مطبوعة في العام 1994م للكاتبة ماريا فيتوريا فونتانا أنَّ الكاتبة نقلت 63 رسماً من القرن السادس الهجري تُصّور روايات عن أهل البيت منقوشة على القاشانيّ والورق والحديد وأشياء أخرى. ويضيف بلوكباشي: أنَّ مؤلّفة الكتاب قسّمَت كتابها إلى قسمين: قسم يضمّ رسوماً للإمام علي بن أبي طالب وأهل بيته، والقسم الآخر يضمّ رسوماً حول شهر محرّم والتاسوعاء والعاشوراء وواقعة كربلاء([310]). ويقول بلوكباشي «أغلب الظنّ أنّ هذه الرسوم والصور الدينيّة انتشرت بين الشيعة الإيرانيّين بشكل بارز في العصر الصفويّ، بعد أن أصبح المذهب الشيعيّ هو المذهب الرسمي للدولة الصفويّة في عصر الشاه إسماعيل الصفويّ (907 ـ 930هـ). ورُسمت صور الأئمّة على الجدران وعلى الستائر (پرده نگاري)، وزُيّنت الكتب بصور الأئمّة»([311]).
«ففي البداية، قام الرسّامون الشعبيّون برسم صور الأنبياء والأولياء والأئمّة من أهل البيت وشهداء كربلاء، ولا سيّما سيّد الشهداء الإمام الحسين× على الستائر الصغيرة والكبيرة، وكانوا يحملونها ضمن مواكب العزاء، التي كانت تسير في الشوارع والأسواق حزناً على الحسين بن علي، حتى يراها المعزون ويشاهدوا مصائب أهل البيت على شكل رسوم وصور»([312]).
وممّا تجدر الإشارة إليه أنَّ رسّام المقاهي كان يرسم صور الأئمّة من أهل البيت ويضع النقاب على وجوههم. وقد سار الرسّامون في النصف الثاني من القرن الخامس عشر وحتى العصر القاجاريّ على هذا الطريق، حيث كان النقاب يغطّي وجوه الأئمّة لكي لا تُرى وجوههم. كما كان النقاب يغطِّي وجوه النساء في العصر القاجاريّ([313]).
وكان أصحاب المقاهي هم أوّل الزبائن لمثل هذه الرسوم؛ لأنّ المقاهي كانت في الماضي تستقبل مختلف شرائح الشعب، وكان القصّاصون والرواة والدراويش يرتادون هذه المقاهي، ويقرأون على الحضور أشعاراً وقصائد عن الحسين وشهداء كربلاء، أو من القصص الحماسيّة المرويّة في كتاب (الشاهنامه) للشاعر الإيرانيّ أبي القاسم الفردوسيّ([314]) كما كانت تُعرض رسوم المقاهي في المآتم والتكايا والمحلّات ونوادي الرياضة التقليديّة المسمّاة (الزورخانات) والحمّامات. فرسوم تعازي عاشوراء كانت تُنصب في التكايا، ورسوم جوانمرد قصاب([315]) كانت تُنصب في محلّات القصّابين([316]).
كانت رسوم المقاهي نتاج ريشة عدد من الفنانين الذين رسموا لوحاتهم بعد استماعهم إلى قصص (الشاهنامة) للشاعر الإيرانيّ أبي القاسم الفردوسيّ، التي تعبِّر عن بطولات أبطال إيرانيّين، أو إلى الخطباء الذين كانوا يشرحون واقعة كربلاء، وبطولات الحسين بن علي في مقارعته جيش يزيد بن معاوية، واستشهاده في ساحة المعركة في كربلاء. أُطلقت على رسوم المقاهي أسماء أخرى مثل (رسوم البرادي أو الستائر) و(رسوم الشمائل) أي رسم صور الأئمّة من أهل البيت الذين استُشهدوا في واقعة كربلاء.
يمكن تقسيم رسوم المقاهي إلى قسمين: الرسوم الدينيّة والرسوم غير الدينية. فالرسوم الدينيّة عبارة عن رسوم وصور لأئمّة أهل البيت، وزعماء الدين، وحروب الرسول|، والأئمّة من أهل بيته منهم الإمام عليّ بن ابي طالب والحسين بن عليّ وأحداث كربلاء([317]). وهناك رسوم أخرى كانت موضوعاتها تشتمل على: سجن الإمام موسى الكاظم×، ودسّ السمّ للإمام علي بن موسى الرضا×، ومعركة خيبر وحروب الرسول محمّد|، وأحداث التاريخ الإسلاميّ، ويوم القيامة، والجنّة والنار، وقتل الحسين، ورسم صورة الإمام علي بن موسى الرضا الملّقب بضامن آهو (ضامن الغزال)([318]).
الرسوم غير الدينيّة عبارة عن مجموعة من الرسوم التي تصوّر قصص الحروب والمعارك والملاحم التي كان أبطالها إيرانيّين، وهي تضمّ أحداثاً تاريخيّة وأُسطوريّة وملحميّة، وترسم صور الملوك وأبطال كِتاب (الشاهنامة) للشاعر أبو القاسم الفردوسيّ، لا سّيما الأبطال الإيرانيّين رستم وسياوش، وميادين القتال ومشاهد حبّ الأبطال، ومجالس الملوك ([319]).
تعكس رسومُ المقاهي الشعبيّة معاناةَ رسّامين يعشقون هذا الفنّ، وهم ممّن جرّبوا الحرمان والفقر، وعايشوا عامّة الناس وعملوا في المقاهي الشعبيّة، وفي عزلة عن الآخرين، ورسموا أبطال واقعة كربلاء، وعكسوا حكايات المظلومين وظلم الظالمين، وكانوا يرسمون بأقلامهم ودموعهم تنهمر على مصائب الحسين وأصحابه([320]). كان كثير من الرسّامين يرسمون معركة كربلاء وبطولات الحسين وأصحابه وأهل بيته، وهم متيّمون بالحسين وأهل بيته، ويعتقدون بأنّ الحسين لم يُهزم في كربلاء، لأنّ الهزيمة لا معنى لها. ويقول الرسّام محمّد مدبّر «إنّنا عندما نرسم معركة كربلاء، نظهر إخلاصنا لرجال عظام كالإمام الحسين، ويتساءل هل هُزم الإمام الحسين في كربلاء؟ ويجيب: إنَّه كان نصيراً للمظلومين والفقراء والمعوزين، فالحسين حيّ يرزق، والموت أصاب الرجال الذين نلعنهم منذ ألف عام»([321]).
ويرى الرسّام الإيرانيّ محمّد فراهاني «أنّ رسم صور الأئمّة من أهل بيت رسول الله له قدسيّة خاصّة (ويضيف) إنّنا عندما نرسم صور الأئمّة، لا بدّ أن نتوضّأ، ولا يمكن أن نبدأ عملنا من دون أن نكون على وضوء؛ لأنّنا نعرف صورةَ من سنرسم، إنّنا نبدأ الرسم بكلّ إخلاص، ونقف أمام ربّنا وأئمّتنا المعصومين»([322]).
أمّا الرسّام حسن إسماعيل زاده فهو عندما يرسم صور الأئمّة من أهل البيت، يبرز على وجوههم علامات القوّة والصلابة والعزيمة وكذلك الحزن. ونحن نرى هذه الصفات في صور الإمام عليّ بن أبي طالب×، والإمام الحسين بن علي×، والعبّاس بن علي× المرسومة بريشة هذا الرسّام([323]) إنّه يرسم وجوه أئمّة أهل البيت غير مغطاة.
وعاش الرسّام علی رضا قوللر آغاسي في العصر القاجاريّ، وكان من أبرز الرسّامین الذین رسموا للطبقات المُعدَمَة والفقيرة، وكانت رسومه تُعرض في الحسينيّات والمقاهي التي يرتادها العمال الفقراء. وجاء بعده ابنه حسين الذي سار على نهج والده. فرسوم المقاهي كانت تُنقل من الأستاذ إلى تلميذه حيث يتلّقى التلميذ التجارب من أستاذه. وهناك رسّامون آخرون خَلّدوا برسومهم فنّ الرسم الشعبيّ ومنهم سيّد رسول إماميّ([324]).
والجدير بالإشارة أنّه برز في السنوات الماضية اهتمام بجمع رسوم المقاهي المرتبطة بواقعة عاشوراء؛ من أجل دراستها واستخراج قضايا تتعلّق بالتعزية في إيران، وكيف كان الرسّامون الإيرانيّون ينظرون إلى واقعة كربلاء، وكيف كانوا يرسمون الشخصيّات التي لعبت دوراً كبيراً في يوم عاشوراء، وخصوصاً الإمام الحسين، والعبّاس بن علي، والحرّ بن يزيد الرياحيّ، وعليّ الأكبر، وعليّ الأصغر والقاسم بن الحسن والمختار بن عبيدة الثقفيّ، وعبيد الله بن زياد.
هل تأثّر رسّامو المقاهي بالرسّامين الأوروبيّين؟
يطرح الكاتب الإيرانيّ محمّد جعفر محجوب رأياً جديداً حول رسوم المقاهي، ويقول بأنّ الرسوم الدينيّة من المحتمل أن تكون قد تأثّرت برسوم روفائيل سانزيو ومايكل أنجلو، التي نُقلت إلى إيران وشاهدها الرسّامون الإيرانيّون. ولكنّ الكاتب الإيرانيّ علي بلوكباشي ينفي هذا الاحتمال، ويرى بأنّ محمّد جعفر محجوب هو وحده الذي يُعِدّ مسرح التعزية في إيران متأثّراً بالمسرح الأوروبيّ ومنقولة عنه([325]).
في كلّ الأحوال، يطرح القائلون بتأثّر الرسّامين الإيرانيّين بفنّ الرسم الغربيّ ما نُقل عن الشاه عبّاس الصفويّ أنّه استدعى رسّامين أوروبيّين إلى بلاطه، وأرسل رسّامين إيرانيّين إلى إيطاليا، ونُقل عن سائح غربيّ زار مدينة تبريز في العام 949هـ ـ 1539م أنّه شاهد مراسم عزاء الشيعة في يوم عاشوراء، ورأى صوراً مرسومة على أقمشة وقال شارحاً مراسم عاشوراء: «كان الناس يجلبون معهم صوراً ورسوماً منقوشة على أقمشة وستائر عن حياة شهداء كربلاء إلى مراسم العزاء»([326]). والذي ينظر إلى رسوم المقاهي والرسّامين الإيرانيّين الذين رسموها يرى أنّ هذه الرسوم بريشة رسّامين شعبيّين فقراء، كانوا يرتادون المقاهي الشعبيّة، وكانوا يرسمون صور الأئمّة من أهل البيت، أو ساحات المعركة في كربلاء، ويعرضونها على رواد المقاهي، وهم في وضع لم يسمح لهم بزيارة البلدان الأوروبيّة ومشاهدة رسوم روفائيل ومايكل انجلو والتأثّر بها.
قرّاء المراثي يستخدمون رسوم المقاهي
كان النائحون وقرّاء المراثي في القرن الماضي يحملون معهم رسوم وصور أئمّة أهل البيت المنقوشة على الأقمشة والستائر، وكان يُطلَق على هؤلاء (پرده خوان ها) أي الذین یقرأون المراثي بالنظر إلى رسوم وصور الأئمّة المرسومة على الأقمشة، وهؤلاء كانوا يشرحون بطولات الأئمّة في مواجهة الأعداء.
وينقل المؤرّخون أن قرّاء المراثي كانوا يجمعون الناس في الساحات العامّة والأسواق، ويبدأون بقراءة أشعارٍ في رثاء الحسين وأهل بيت رسول الله، وعند تجمّع المارّة كان هؤلاء يفتحون الستائر التي رُسِمت عليها وقائع عاشوراء أو صور الأئمّة، ويبدأون شرح الأحداث التي مرّت على أهل البيت([327]). ويرجع المؤرّخون بداية ظهور قرّاء المراثي إلى العصر الصفويّ في القرن العاشر الهجريّ ولا سيّما في عهد الشاه عبّاس الصفويّ الذي كان يشجّع على قراءة المراثي.
كتب العديد من السيّاح والمستشرقين الذين زاروا إيران في القرن السابع عشر وحتى القرن العشرين مذكّراتهم ومشاهداتهم عن العزاء في إيران، وأرفقوها برسوم عن مجالس العزاء.
فالسائح الفرنسيّ جان شاردن ـ الذي زار إيران في القرن السابع عشر للهجرة، أي في العهد الصفويّ، وكتب مذكّراته في كتابه (رحلة شاردن) ـ أرفق مذكّراته برسمٍ عن مراسم العزاء، وخروج المواكب إلى الشوارع والساحات العامّة. كما أرفقت السائحة الفرنسيّة مدام جان ديولافوا مذكّراتها عن إيران برسم عن مراسم العزاء أو الشَّبيه في الهواء الطلق. ورسم الرسّام الإيرانيّ كمال الملك([328]) صورةً من داخل تكيّة دولت التي بنيت في عصر الحاكم ناصر الدين شاه القاجاريّ (1848 ـ 1897م) في طهران لإقامة عروض التعزية، وهذا الرسم موجود الآن في متحف قصر غولستان في طهران.
أفلام وثائقيّة عن العزاء الحسيني
حَظِي عزاء الحسین منذ سنوات باهتمام السينمائيّين الإيرانيّين الذين أرادوا تصوير مجالس العزاء ولا سيّما عروض التعزية، في مختلف مناطق إيران، وبشكل خاصّ في القرى والمدن النائية التي لم تتوقّف فيها عروض التعزية على الرغم من منع السلطات الإيرانيّة لها في القرن الماضي، ومن أجل عرضها على الإيرانيّين والمهتمين بمسرح التعزية الإيرانيّ في الخارج.
بدأ السينمائيّون الإيرانيّون والأجانب في السبعينات من القرن الماضي بإنتاج أفلام عن التعزية؛ من أجل عرضها على الباحثين والدارسين والمهتمّين بعروض التعزية.
تمّ إنتاج فيلم في باريس في 1975 ـ 1976 بعنوان: (تعزيه شير خدا در نطنز) [تعزیه أسد الله في نطنز] عن وحدة البحوث في باريس. كما تمّ إنتاج فيلمين عن التعزية في القرى الإيرانيّة بعنوان (تعزيه در اراك وتعزيه در شيراز) [التعزية في أراك والتعزية في شيراز]([329]).
أنتج المخرج الإيرانيّ (برویز صیاد) فیلمین وثائقیّین هما: (مجلس تعزیة خروج المختار) و(مجلس تعزیة عبد الله عفیف). وقد عُرض فيلم (مجلس تعزية عبد الله عفيف) في إحدى دور العرض في طهران في العام 1338هـ.ش [1959م] كما عرضه التلفاز الإيرانيّ. وأُنتج فيلم آخر بعنوان (تعزية الحرّ) من إخراج (خجسته كيا) وعُرض الفيلم أيضاً في التلفزيون الإيرانيّ. وأنتج سكاريان فيلم آخر بعنوان (تعزية الحر) في العام 1976م. وكانت مجموعة مسرحيّة في مدينة قم الإيرانيّة قد أخرجت هذه المسرحيّة علی مسرح حسينيّة نياوران([330]).
وأنتج المخرج الإيراني (برويز كيمياوي) سبعة أفلام عن التعزية، وعُرضت جميعها في مهرجان الفنّ في شيراز في العام 1976م. وقام (طاهري دوست) بتصوير عدّة عروض مسرحيّة للتعزية في قرى حبيب آباد بالقرب من مدينة إصفهان (وسط إيران). كما أنتج المخرج الإيرانيّ (ناصر تقوائي) فيلماً عن مراسم وطقوس أربعينيّة الإمام الحسين في مدينة بوشهر الإيرانيّة (جنوبيّ إيران)([331]).
وأنتج (أمين بناني) أستاذ جامعة كاليفورنيا فيلماً طويلاً وفيلمين قصيرين عن التعزية. الفيلم الطويل كان يصوّر مجموعة هواة تقوم بإخراج مسرحيّة تعزية في قرية قريبة من مدينة همدان الإيرانيّة خلال شهر محرّم من 1966م. كما أخرج الفيلمين القصيرين على طريقة كولاج Collages؛ أي تصوير لقطات متقطّعة وعرضها بصورة متتالية([332]).
بعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران في العام 1979م، بادر السينمائيّون الإيرانيّون إلى تصوير واقعة عاشوراء، فأنتجوا فيلماً بعنوان (السفير) [سفير الحسين] والمقصود منه مسلم بن عقيل، الذي أرسله الإمام الحسين إلى الكوفة؛ لكثرة الرسائل التي جاءت إليه تدعوه للتوجّه إلى الكوفة؛ لاستطلاع الأمر، ومعرفة إن كانوا مخلصين له أم لا. الفيلم أنتجه في العام 1980 ـ 1981م الحرس الثوريّ والتلفزيّون الإيرانيّ بصورة مشتركة، وبتشجيع من أحد قادة الجيش الإيرانيّ الشهيد يوسف كلاهدوز. هو أوّل فيلم أُنتج حول واقعة عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين. ومع أنّ الكثيرين من السينمائيّين عارضوا إنتاج هذا الفيلم بسبب رهبتهم وخوفهم من تصوير لقطات هذه الفاجعة للمرّة الأولى، إلّا أنّ الفيلم أُنتج وعُرض في السينما والتلفزيون في إيران.
تمّ إنتاج فيلم آخر في العام 1994م في إيران موضوعه واقعة عاشوراء، وأُطلق عليه اسم (روز واقعة) [يوم الواقعة] أي يوم عاشوراء وهو من إخراج (شهرام أسدي) وكتبَ السيناريو المخرج السينمائيّ المعروف بهرام بيضائي. يبدأ الفيلم بوصول شابّ مسيحي أسلم للتوّ واسمه عبد الله إلى كربلاء، وهذا الشاب يعشق فتاة اسمها راحلة بنت زيد، وخلال الزواج مع راحلة يسمع منادياً يناديه ويطلب منه المساعدة. يتوجّه عبد الله وراء النداء ليصل إلى كربلاء بعد واقعة الطف، يرى الحسين وأصحابه وقد استُشهدوا على أرض المعركة، ورُفعت رؤوسهم على الرماح([333]).
يبتعد السينمائيّون عادة عن تصوير أرض المعركة والقتال بين الحسين وأصحابه وجيش بني أميّة؛ ربما لتلافي نقد رجال الدين لهم، ولأنّه موضوع حسّاس يثير الجدل كما هو الحال بالنسبة إلى الموضوعات المتعلّقة بعاشوراء.
منذ إنتاج هذا الفيلم بدأ السينمائيّون الإيرانيّون إنتاج أفلام ومسلسلات ترتبط بعاشوراء وحياة الأئمّة من أهل البيت، فتمّ إنتاج فيلم (تنها سردار) [القائد الوحيد] أي الإمام الحسن بن علي× و(ولاية العشق) فيلم عن حياة الإمام علي ابن موسى الرضا×، والوقائع السياسيّة والاجتماعيّة في عصره.
وعند اندلاع الحرب العراقيّة الإيرانيّة، أنتج العديد من المخرجين أفلاماً عن الحرب ومقاومة الإيرانيّين مقابل جيش الرئيس العراقيّ السابق صدام حسين، ويشبه مضمونُ الكثير من الأفلام مضمونَ واقعة عاشوراء وصمود الحسين أمام جيش يزيد. ومن أهمِّ هذه الأفلام فيلم (پرواز در شب) [التحليق في الليل] للمخرج رسول ملا قلي بور، حيث أشار الفيلم إلى دور العبّاس بن علي× في سقي أطفال الحسين يوم عاشوراء.
كما أنتج الإيرانيّون مسلسلات معروفة في تاريخ السينما الإيرانيّة منها مسلسل (سربداران) [الذين عُلّقت رؤوسهم على المشانق] و(شب دهم) [الليلة العاشرة] و(أم وهب) و(سفر سبز) [السفر الأخضر] و(باران عشق) [مطر العشق] وكلّها مرتبطة بواقعة عاشوراء.
وهناك فيلم استمدّ موضوعه من عاشوراء ومن بطولات شهداء كربلاء، أُطلق عليه (شب عاشورايي) [ليلة عاشورائيّة] أخرج الفيلم المخرج الإيرانيّ (سيّد مرتضى آويني) في العام 1986م، صوّر الفيلم الحالة الروحانيّة للقوّات الإيرانیة قبل ساعات من بدء (عمليات الفجر) ضدّ قوات صدّام في مدينة الفاو العراقيّة. الفيلم وثائقيٌّ من مجموعة الأفلام الوثائقيّة التي أخرجها (سيد مرتضى آويني) عن الحرب باسم (روايت فتح) [رواية الفتح].
وأنتج المخرج السینمائيّ (أحمد رضا درويش) فيلم (رستاخيز) [یوم القيامة] يتحدّث عن يوم عاشوراء واستشهاد الحسين بن علي([334]).
ومن المقرّر أن يتمّ إنتاج
فيلم تاريخيّ ـ دينيّ عن حياة الإمام الحسين×، وأنصاره وصمودهم يوم عاشوراء. وسیُطلَق
علیه اسم (ثار الله) وخُصّصت مبالغ كبيرة لإنتاج هذا الفيلم الذي سیكون فيلماً ضخماً
إذا ما قُورِن بالأفلام التي أُنتجت سابقا([335]).
|
الفصل الرابع
التأثير المتبادل بين العرب والإيرانيين
شهدنا في طقوس إقامة العزاء الحسيني ولا سيّما أيام العشرة الأولى من شهر محرّم، تشابهاً كبيراً بين هذه الطقوس عند الشيعة الإيرانيّين والعراقيّين والعرب الآخرين والآسيويّين. ويبدو أنّ التفاعل الوجدانيّ كان كبيراً ومشهوداً بين الإيرانيّين والعراقيّين في إقامة طقوس التعزية؛ نظراً لزيارة الإيرانيّين والعراقيّين للعتبات المقدّسة في العراق وإيران.
فكثير من طقوس التعزية التي تقام الآن في العراق هي نفسها تجري في إيران، بل إنّ الكثير منها طبق الأصل، ولا تختلف في البلدين، ولا يمكن معرفة البادئ بهذه الطقوس إلّا بالرجوع إلى المصادر والمراجع التي تحدّثت عنها.
فطقوس عاشوراء في إيران كانت قد اكتملت في العصر الصفويّ، واستمرّت حتى عهد رضا شاه بهلويّ الذي منع إقامة طقوس التعزية ومراسم عاشوراء حتى سقوطه ونفيه إلى خارج إيران، ومن بعده استُؤنِفت الطقوس ووصلت إلى ما هي عليه حتى الآن.
أُقیمت طقوس عاشوراء في العراق منذ مئات السنين، وكانت تُمنع من قبل بعض الحكّام، وعندما كان يتغيّر الحكام يعود الناس إلى إقامة التعازي وطقوس عاشوراء. عندما وصل حزب البعث في العراق إلى السلطة في العام 1968 منع إقامة الطقوس في عاشوراء حتى سقط نظام البعث في العراق في العام 2003م، واستمرّت هذه الطقوس بعد سقوط نظام صدام حسين حتى الآن وبصورة أكبر وأوسع.
مجالس العزاء متشابهة في إيران والعراق والبلاد العربيّة والإسلاميّة، حيث هناك المساجد والحسينيّات والتكايا والبيوت التي تُقام فيها هذه المجالس، وهناك المنبر الذي يجلس عليه الخطيب، والمستمعون الذين يجلسون للاستماع إلى الخطيب، ومن ثمّ يقوم الرادود أو النائح بقراءة الشعر الحسينيّ، وتكون نهاية مجلس العزاء، اللطم على الصدور.
والمواكب الحسينيّة هي الأخرى متشابهة بين إيران والعراق وبلدان أخرى منها السعوديّة والبحرين ولبنان وسوريا وتركيا والباكستان والهند. حيث تخرج هذه المواكب إلى الشوارع والميادين، ويردّد المشاركون فيها أشعاراً في رثاء الحسين وأهل بيته، ويحمل المشاركون في المواكب أعلاماً سوداء وملوّنة، ولافتةً كُتب عليها اسم الموكب.
ومواكب الزنجيل التي تُقام في العراق والبلاد العربيّة هي نفسها التي تُقام في إيران، ولا يمكن معرفة من تأثَّر ومن أثر في الآخر في إقامة هذا الطقس.
ومواكب التطبير ـ التي تُقام حاليّاً في العراق ولبنان، ومُنِعت في إيران كما أشرنا من قبل ـ متشابهة إلى حدّ ما، وتذكر كتب التاريخ أنّها نُقلت من إيران إلى العراق.
كما أنَّ طقوساً خاصّة في التعزية، أُقيمت في العراق واقتبسها الإيرانيّون وصبغوها بصبغة إيرانيّة، وخير مثال على ذلك (ركضة طويريج) التي تُقام في يوم عاشوراء في كربلاء، وهي موكب عزاء ينطلق من مدينة طويريج التي تبعد حوالى 20 كيلومتراً شرقيّ مدينة كربلاء، ويقوم المشاركون بالركض والهرولة باتجاه مدينة كربلاء، وفي الطريق يلتحق أهالي المدن والقرى بهذا الموكب، الذي يضمّ مئات الآلاف من المواطنين يردّدون فيها شعارات: يا حسين يا حسين.
كما أنّ التشابيه التي تُقام في العراق في أيام العشرة الأولى من شهر محرّم هي نفسها التي تُقام في إيران، حيث يخرج موكب يضمّ عدداً كبيراً من الأفراد يرتدون ثياباً حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء، يمثّلون أهل البيت وأعداءهم وهم يركبون الخيول، والبعض منهم راجلون يتبارزون في الميادين تشبّهاً بواقعة كربلاء.
وطقوس حرق الخيام التي هي عادة عند العراقيّين يوم العاشر من شهر محرّم، تُقام أيضاً في المدن الإيرانيّة ومنها طهران وقم وإصفهان، حيث تُنصب خيمة كبيرة وسط إحدى الساحات تمثّل خيمة أهل بيت الحسين يوم عاشوراء، والتي قام جيش ابن زياد بحرقها بعد مقتل الحسين يوم عاشوراء.
كما أنَّ مراسم (عرس القاسم) التي تُقام الآن في العراق ولا سيما في كربلاء ليلة العاشر من محرّم نُقلت بحذافيرها من إيران، وكانت هذه المراسم قد أُقيمت منذ عشرات السنين في العراق، ولا تزال تُقام في كربلاء ليلة العاشر من محرّم، حيث يحمل أطفال ويافعون شموعاً بيضاء مضاءة، يسيرون في صفوف متوازية يردِّدون أبياتاً من الشعر في موكب كبير، وترمز إلى زفاف القاسم بن الحسن بن علي بن ابي طالب ليلة العاشر من محرّم.
كانت صور الأئمّة من أهل البيت تُرسم في العراق على لوحات كبيرة، وتُوضع على أبواب الحسينيّات والمساجد وفي داخلها، وتُحمل مع المواكب التي كانت تنطلق من المساجد والحسينيّات، وهذه الصور منشؤها إيران، ونُقلت منها إلى العراق. ولا زالت صور رأس الإمام الحسین تُحمل مع مواكب العزاء في المدن العراقيّة.
حملُ المشاعل مع مواكب العزاء بدأ في العراق، وكان يحملها شبّان أقوياء وتدلّ على عظمة كلّ موكب عزاء، ومدى جاهزيته في إقامة العزاء الحسينيّ وإحياء ذكرى الإمام الحسين. في إيران تُحمل مع العديد من المواكب مشاعل تُعلّق بها مصابيح كهربائيّة وعلامات وقطع خشبيّة ترمز إلى نعوش الشهداء، وقد تطوّرت على مرّ الأزمنة.
حملُ التوابيتِ عادةٌ مأخوذةٌ من الإيرانيّين، وترمز إلى استشهاد أصحاب الحسين وأهل بيته في كربلاء، وهذه العادة تُمارَس في الهند والعديد من البلدان الآسيويّة ويُطلق عليها أسماء مختلفة.
وأخيراً، تشهد المدن العراقية مراسم المشي سيراً على الأقدام إلى كربلاء بمناسبة أربعينيّة الإمام الحسين، ويشارك فيها الملايين من العراقيّين والعرب والإيرانيّين والأجانب. وفي النبطيّة في جنوب لبنان، يشارك اللبنانيون ولا سيّما النساء في مراسم المشي على الأقدام بين النبطيتين الفوقا والتحتا([336]).
وفيما يلي ندرس كلّ فقرة بما توفّر لنا من معلومات:
تُقام مجالس العزاء الحسيني في إيران والعراق والبلدان العربيّة والإسلاميّة وحتى البلدان الأوروبيّة التي يتواجد فيها الشيعة. وهذه المجالس تُقام منذ مئات السنين، وقد شجّع الأئمّة من أهل البيت على إقامتها، وكانت مجالس العزاء تُقام حيث يقرأ الشاعر قصيدة في رثاء الحسين، فيبكي المستمعون.
تطوّرت مجالس العزاء على مرّ السنين؛ حيث كان الخطباء يأخذون في قراءة التعزية على الحسين وشرح واقعة كربلاء لمستمعيهم، ويُختم المجلس بقراءة رادود أو نائح جميل الصوت أشعاراً في رثاء الحسين، ويلطم المشاركون على صدورهم. وفي العصر الحاضر تُقام مجالس العزاء في الحسينيّات والمساجد والبيوت والتكايا في إيران والعراق وبلدان أخرى، ويكون مكان عقد المجلس في الغالب مغطى الجدران بالسواد. تبدأ مجالس العزاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعد ذلك يصعد الخطيب على منبر أُعِدَّ في المسجد أو الحسينيّة، ويبدأ بقراءة أشعار أو آيات من القرآن، بعدها يقوم بتفسير الآيات، ويطرح قضايا معاصرة، تهمّ المشاركين في مجلس العزاء، تشتمل على الوعظ والإرشاد وعلى جانب من سيرة الحسين× وبعض الفصول من مأساة كربلاء، ثمّ يختم حديثه بقراءة أبيات من الشعر الفصيح أو الشعبيّ في رثاء الحسين×. قد يتعاقب أكثر من خطيب وقارئ على المنبر الواحد بحسب سعة المجلس وصغره، وفي ختام كلمته يشير إلى واقعة كربلاء ومقتل الحسين، ويقرأ بعض الأشعار في رثاء الحسين سواء كانت أشعاراً فصيحة أو باللهجة المحليّة، بعدها يصعد النائح أو الرادود على المنبر ويقرأ أشعاراً في رثاء الحسين، وأهل بيته ويلطم المشاركون على صدورهم، وبعدها ينصرف المشاركون أو يُقدَّم لهم الطعام.
خلال القرون الماضية تخصّص عدد كبير من رجال الدين في قراءة مجالس العزاء، وأُطلق على هؤلاء أسماء مختلفة منها (الخطيب) أو (خطيب المنبر الحسينيّ)، والواعظ. وبرز عدد كبير من الخطباء كان منهم في العراق الكثيرون كالسيد صالح الحلي، والشيخ هادي الكربلائي، والشيخ عبد الزهراء الكعبي والشيخ أحمد الوائلي، ومن الاحياء الشيخ فاضل المالكي، والشيخ جعفر الابراهيمي، وغيرهم الكثير ممن حمل مسؤولية التبليغ عن النهظة الحسينية. كما برز خطباء كبار في إيران منهم ملا حسين واعظ كاشفي الذي عاش في القرن العاشر للهجرة، والشيخ أحمد الكافي، والمرحوم الشيخ الفلسفيّ، ومن الخطباء الإيرانيّين المعروفين الأحياء الشيخ حسين أنصاريان، والسيد عبد الله فاطمي نيا.
ويشارك في مجالس العزاء الرواديد أو النائحون الذين يقرأون أشعار الرثاء على الحسين وأهل بيته. وبرز خلال السنوات الماضية رواديد ونائحون في العراق وإيران والبلدان العربيّة والإسلاميّة، يصعدون المنابر ويقرأون أشعاراً كتبوها هم أنفسهم أو كتبها لهم شعراء آخرون، ويقوم المشاركون باللطم على صدورهم. ومن أبرز النائحين العرب العراقيّين المرحوم حمزه الصغير أو الزغير، والشيخ ياسين الرميثي، والملا باسم الكربلائيّ، والملا جليل الكربلائيّ. ومن أبرز الرواديد الإيرانيّين الأحياء حاج منصور عرضي، وصادق آهنكران، وسعيد حداديان، وحاج محمود كريمي.
تخرج مواكب العزاء ليس فقط في إيران والعراق بل في كلّ بلد يوجد فيه الشيعة، وعادة ما يحمل المشاركون في مواكب التعزية رايات سوداء وبيضاء وحمراء وخضراء كُتب علیها اسم الحسين، وعبارات لها علاقة بحادثة كربلاء، كما يرفع المشاركون لافتاتٍ تُسمّي الجهة المؤسِّسة للموكب، أو المنطقة التي خرج منها المعزُّون. ويردِّد المشاركون عادة أبياتاً من الشعر في رثاء الحسين. تطوّرت مواكب العزاء في العراق في منتصف القرن الماضي بحيث اختلط السياسيّ بالدينيّ، وردّد المشاركون أشعاراً سياسيّة ضدّ الحكومة، ممّا دعا الحكومات المتعاقبة إلى منع خروج المواكب الحسينيّة، أو إلي حصول اشتباكات بين المشاركين في المواكب وقوّات الأمن والشرطة، وقتل العديد من المواطنين. وقد تحدّى العراقيّون سلطات البعث في الخروج بمواكب عزاء في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وردّدوا شعراً متحَدِّين السلطات ومؤكّدين على الخروج في المواكب حتى ولو تعرّضوا للقمع:
|
لو قطعوا أرجلنا واليدين |
ولم يكن منع مواكب التعزية محصوراً بالعراق، بل إنّ الحكومة الإيرانيّة في عصر رضا شاه بهلوي (1926 ـ 1941م) منعت خروج المواكب وإقامة التعزية العاشورائيّة. وعادت مواكب العزاء إلى سابق عهدها؛ نتيجة تنحيته عن الحكم ونفيه إلى خارج إيران. كما أنّ وصول حكومات غير شيعيّة إلى حكم إيران بعد البويهيّين وقبل وصول الصفويّين إلى الحكم كان سبباً لمنع التعزية العاشورائيّة في إيران لعدّة قرون.
وبعد انتصار الثورة الإسلاميّة في إيران في العام 1979م، شجّعت الحكومة الإيرانيّة إقامة التعزية، وخروج مواكب العزاء؛ كونه تعظيماً للشعائر الإسلاميّة وعملاً بالآية الكريمة: (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) ([337]).
الجدير بالذكر أنّ مجالس عروض التعزية تُقام في شهر محرّم في المدن الإيرانيّة، وكانت هذه المجالس تُقام كلّ ليلة من ليالي العشرة الأولى من شهر محرّم، وتختصّ بأحد الأئمّة أو أحد أبناء أهل البيت. فعلى سبيل المثال كان يُقام مجلس تعزية استشهاد الإمام علي×، وفي الليلة التالية مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسن، ومجلس تعزية الإمام الرضا، ومجلس تعزية العبّاس بن عليّ، ومجلس تعزية علي الأكبر ومسلم بن عقيل وطفليه، وشبيه المختار، ووصول أهل بيت الحسين إلى الكوفة والشام.
تُقام أيضاً مواكب الزنجيل أو السلاسل في كلّ من العراق وإيران والعديد من البلدان العربيّة، منها المنطقة الشرقيّة في السعوديّة والمدن والقرى في البحرين. يضمّ موكب الزنجيل رجالاً يرتدون ثياباً سوداء منحسرة عن الظهر حتى الكتفين يحملون بأيديهم مجموعات من السلاسل الحديديّة، يتراوح طول السلسلة منها بين سبعة وعشرة إنشات، وجميعها تتصل بحلقة حديديّة مثبتة في مقبض خشبيّ، يرفعونها بكلتا اليدين ويهوون بها على ظهورهم أو أكتافهم، وذلك على وقع نغمات خاصّة تصدر عن ضرب الطبول والصنوج أمام الموكب، ويردّدون أبياتاً من الشعر في رثاء الحسين× على إيقاع تلك النغمات([338]). تُقام مواكب الزنجيل في الهند والباكستان مثل ما تُقام في إيران والبلدان العربيّة، ويشارك الشيعة في هذه المواكب، ويحملون معهم السلاسل المزوّدة بسكاكين صغيرة، حيث تخرج الدماء عندما يضربون ظهورهم، وقد منعت السلطات الإيرانيّة الحالية استخدام الزناجيل المزوّدة بالسكاكين لمنع تشويه الشعائر الحسينيّة.
كذلك منعت الحكومة الإيرانيّة في الثمانينات من القرن الماضي مواكب التطبير في أنحاء إيران بعد أن كانت هذه المواكب تخرج في العديد من المدن. وقد أعلنت الحكومة الإيرانيّة بأنّ مواكب التطبير تشوّه الشعائر الحسينيّة ويستغلّ أعداء الإسلام هذه الطقوس ليهاجموا الإسلام، وينسبوا إلى المسلمين هذه الأعمال التي تصوّر المسلمين وهم يقومون بجلد الذات وتعذيب النفس. واقترحت الحكومة الإيرانيّة على من كانوا يشاركون في هذه الطقوس التبرّع بدمائهم بدل التطبير لمساعدة المرضى والمحتاجين إلى الدَّم.
وفي العراق تخرج مواكب السيوف، أو التطبير في اليوم العاشر من محرّم في مدينة كربلاء والمدن الاخرى، ويشارك في مواكب التطبير الشباب والشيوخ وحتى الأطفال حيث يضربون رؤوسهم بالسيوف والمدى والقامات، وعند الانتهاء من هذا الطقس يذهب المطبّرون إلى الحمّامات؛ لغسلوا رؤوسهم وأبدانهم. وليضعوا الضّمّادات على الجرح. أحياناً يُصاب بعضهم بالضعف أو الانهيار، فيُحمل فوراً إلى المستوصف الخاصّ بهم لإجراء ما يلزم([339]).
وكانت الحكومات العراقيّة المتعاقبة قد منعت العزاء الحسيني مطلقاً ولا سيّما في عهد حكومة صدام حسين، وكان منها التطبير، ولكن بعد سقوط نظام حزب البعث عاد العزاء الحسيني بكلِّ أشكاله من جديد إلى العراق ومن ضمنه التطبير ولا تزال هذه الطقوس مستمرّة حتى وقتنا الحاضر.
وتشهد مدينة النبطيّة اللبنانيّة صبيحة يوم عاشوراء من كلّ عام خروج موكب التطبير وضرب الرؤوس بالسيوف والخناجر، يشارك فيها الرجال من شباب وشيوخ وأطفال.كما نشرت وسائل الإعلام اللبنانيّة في العاشر من محرّم سنة 1435هـ/ت2 ـ نوفمبر 2014) لأوّل مرّة صوراً عن شباب يقومون بالتطبير في الضاحية الجنوبيّة من بيروت. كانت هذه الطقوس موضع خلاف بين علماء لبنان منهم من حرّمها، وعلى رأسهم آية الله السيد محسن الأمين العامليّ، ومنهم من عدّها شعيرة من شعائر الإسلام وشجّع على إقامتها كعبد الحسين صادق. تُقام مراسم العزاء في النبطيّة كلّ عام ومن أبرز الفعاليات هناك تمثيل واقعة استشهاد الحسين على مسرح النبطيّة.وتجدر الإشارة إلى أنّ هنالك مواكب تسير في النبطيّة، يشارك فيها الشباب المعارضون لأعمال التطبير، بعد انقضاء العاشر من محرّم بيوم أو يومين.
منذ عشرات السنين يحمل المشاركون في مواكب العزاء في العراق وإيران مشاعل كبيرة؛ لإنارة الموكب. يحمل المشعل رجل قويّ البنية، ويدور به في الساحة العامّة، ويبدو أنّ المشعل كان يُحمل مع المواكب قبل وصول الكهرباء إلى العراق. كانت المشاعل التي تُحمل في مواكب العزاء مختلفة الأحجام؛ منها ما يبلغ طوله خمسة أمتار، ومنها ما يبلغ طوله مترين أو ثلاثة أمتار، وكانت تزيَّن بمصابيح نفطيّة، تُوضع على المشعل، ثمّ استُعيض عنها بمصابيح غازيّة، وأخيراً بمصابيح كهربائيّة. كما استعاضت مواكب العزاء والزنجيل في إيران والعراق أخيراً عن المشاعل الكبيرة بشمعات كهربائيّة؛ بسبب خفّة وزنها وقلّة مشاكلها، وتُوضَع المصابيح والشمعات على عربة أو سيارة، وتتحرّك مع حركة موكب العزاء والزنجيل. كذلك كانت تُحمل مشاعل صغيرة مع مواكب العزاء، منعاً لما يمكن أن يحصل من حريق خلال حمل المشاعل الكبيرة ووقوع خسائر وضحايا.
طويريج هو أحد الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء ويبعد عن كربلاء 22 كيلومتراً. ولكون الركضة تبدأ من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج فسمّيت الممارسة بركضة طويريج. والقنطرة تبعد حوالى خمسة كيلومترات عن مركز المحافظة. تبدأ الركضة بعد أذان الظهر يوم عاشوراء كلّ عام، بالضبط وهو الوقت الذي سقط فيه الإمام الحسين صريعاً على رمضاء كربلاء. وكأنّ هذه الحشود جاءت لنصرة الحسين×، ولكنّها وصلت متأخّرة، ولم تستطع الوصول قبل مصرع الإمام. لذلك يلطمون على الرؤوس: وينادون (يا حسين يا حسين)، (أبد والله ما ننسى حسيناه)، (يا عبّاس جيب الماي لسكينة)، فينطلقون من القنطرة مروراً بشارع الجمهوريّة فشارع الإمام الحسين في كربلاء، ثمّ يدخلون إلى الضريح الشريف من باب القبلة، ويخرجون من الباب المقابل لمرقد أبي الفضل العبّاس فيجتازون منطقة بين الحرمين وتكون قد انتهت هذه الممارسة الحسينيّة. إنَّ منظر هذه الجموع البشريّة وهي تزحف نحو كربلاء وتدخل مرقد الإمام الحسين وأخيه العبّاس وصوتها الهادر بالنداء يا حسين يا حسين يظهر المحبّة والوجد لآل البيت^، ويجعل المرء يشعر بروحانيّة الموقف، وعظمة المناسبة.
يُرجِع أحد المؤرّخين نشأة الركضة إلى بني أسد الذين جاؤوا في اليوم الثاني من مقتل الحسين إلى أرض كربلاء، فوجدوا أجساداً من دون رؤوس، وهنا بدأوا البحث عن جسد الحسين مردّدين عبارة «الله الله حسين وينه»، ويضيف المشاركون في العزاء عجز البيت: «بالسيوف مقطعينه». ولما كانت هذه الركضة توقع الأثر في النفوس، وكانت تستقطب أكبر عدد من المعزِّين بمصاب الحسين×، انتشر اسمها وطريقتها في إيران. فقد انتشرت في مدينة قم حيث تتمّ الركضة فيه من غلزار شهدا [روضة الشهداء] وحتى مرقد السيدة فاطمة المعصومة. ويشارك فيها جمع غفير من المواطنين كلّ عام.
ويقيم أهالي طهران هذه الركضة ظهر يوم العاشر من محرّم كلّ عام، وعندما تنتهي الركضة تُحرَق خيمة تُنصَب في وسط مدينة طهران قرب السوق الكبير. كما انتشرت الركضة في مدينة مراغة التي تقع في محافظة آذربيجان الشرقية (غربي إيران) وأهاليها من الأتراك، حيث يقومون بها في صباح العاشر من محرّم من كلّ عام. وتسمّى هذه الركضة باسم (الله الله حسين وينه). فهذه الركضة اقتُبست من ركضة طويريج العراقيّة، ويقوم المشاركون فيها بلبس ثياب بيضاء، ويركضون ويهرولون مردّدين عبارة (الله الله حسين وينه).
وينقل أحد الكتّاب الإيرانيّين بأنّ اثنين من أهالي مدينة مراغة (شمال غربيّ إيران)، وهما الحاج غفار وميرزا تقي البحرينيّ زارا مدينة كربلاء قبل قرنين، ونقلا هذه المراسم إلى بلدتهم مراغة. تبدأ المراسم في حسينيّة الحاج غفار التي تقع وسط مدينة مراغة بعد أداء صلاة الفجر يوم عاشوراء وقراءة الأدعية والأوراد، عندها يخرج المعزُّون في موكب مهيب، يشارك فيه أهالي المدينة، ويهرولون لمسافة سبعة كيلومترات داخل الشوارع والأزقّة في المدينة، ويردّدون عبارة (يا حسين يا حسين)([340]). وهذا أنموذج من النماذج الواضحة على التأثّر والتأثير المتبادلين بين مختلف البلدان التي تؤدّي الطقوس العاشورائيّة.
تجري طقوس حرق الخيام يوم العاشر من محرّم في كلّ عام في كربلاء، حيث تُنصَب خيمة كبيرة بالقرب من منطقة المخيّم في كربلاء، وترمز إلى مخيّمات الحسين، وأهل بيته وأصحابه، حيث قام الجيش الأمويّ بعد قتل الحسين وأصحابه بالهجوم على خيام أهل البيت وأحرقوها، فخرج الأطفال والنساء منها فارّين من ألسنة النيران.
ويقول عليّ بن موسى ابن طاووس في كتابه (اللهوف على قتلى الطفوف): «وتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول وقرّة عين البتول، حتى جعلوا ينتزعون ملحفة المرأة عن ظهرها، وخرج بنات رسول الله| وحريمه يتساعدْنَ على البكاء ويندبنَ لفراق الحُماة والأحبّاء. ثم أخرجوا النساء من الخيمة وأشعلوا فيها النار، فخرجنَ حواسر مسلَّبات حافيات باكيات، يمشين سبايا في أسر الذلّة»([341]).
وجاء في كتاب (حياة الإمام الحسين) «عمد الخبثاء اللئام إلى حرق خيام (الحسين)× غير حافلين بما تضمّ من بنات الرسالة وعقائل الوحي، وقد حملوا أقبسة من النار ومناديهم ينادي: (أحرقوا بيوت الظالمين...). وحين التهبت النار في الخيام فرّت بنات رسول الله| في البيداء، والنار تلاحقهنّ، أمّا اليتامى فقد علا صراخهم وهاموا على وجوههم في البيداء، وهم يستغيثون فلا يجدون من يحميهم ويغيثهم، وكان هول ذلك المنظر من أفجع ما رآه الإمام (علي بن الحسين) زين العابدين، ولم يَغِب عن ذهنه طيلة المدّة التي عاشها بعد أبيه، فكان دوماً يقول: والله ما نظرت إلى عمّاتي وأخواتي إلّا وخنقتني العبرة، تذكرت فرارهنَّ يوم الطف من خيمة إلى خيمة، ومن خباء إلى خباء، ومنادي القوم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين»([342]).
فحرق الخيام في يوم عاشوراء عادةٌ يقوم بها الشيعة في كربلاء، وقد نُقلت هذه الطقوس إلى إيران حيث يقيم أهالي طهران خيمة كبيرة وسط العاصمة. ظهر يوم عاشوراء يقوم أفراد يمثّلون جيش بني أميّة، ويلبسون ملابس حمراء وصفراء، يركبون الخيول، بإحراق الخيمة. ويشاهد هذه الطقوس آلاف المواطنين الإيرانيّين، كما تُقام الطقوس نفسها في مدينة إصفهان (وسط إيران).
تُقام طقوس عرس القاسم في العراق وإيران، وذلك خلال مواكب التعزية التي تقام في شهر محرّم، وينقل الكاتب الإيرانيّ حسين واعظي كاشفي في كتابه روضة الشهداء بأنَّ الحسين زوّج ابنته لابن أخيه القاسم بن الحسن ليلة العاشر من محرّم وذلك تنفيذاً لوصية أخيه الحسن، وقد أُجريت طقوس العرس خلال المعارك التي كانت جارية في كربلاء. ويفنّد العديد من المؤرّخين والعلماء هذه الرواية وينتقدون هذه الطقوس، ويعدّونها مختلَقَة ولا أساس لها في التاريخ، وإنّ واعظي كاشفي هو أوّل من ذكر ذلك في كتابه المنشور في القرن العاشر للهجرة، ومنه أخذ عامّة القرَّاء. وخلال طقوس عرس القاسم التي تجري في العراق وإيران يحمل الأطفال أواني فيها شموع وحنّاء، ترمز إلى عرس القاسم، وذلك خلال ليالي محرّم، كما تُصنع غرف مدوّرة أو مثمّنة الشكل وتوضع فيها المصابيح، ترمز إلى غرفة زفاف القاسم، ويحملها رجل على رأسه ويدور بها، وتُقرأ أشعار عن القاسم الذي استُشهد في كربلاء يوم العاشر من محرّم، وهو لما يبلغِ الحلم. يبدو أنّ الإيرانيّين هم الذين بدأوا هذه الطقوس؛ لأنّ الكاتب الإيرانيّ ملا حسين واعظ كاشفي هو أوّل من ابتدع قصّة عرس القاسم ونقلها عنه العديد من الكتّاب الشيعة العرب.
نقل السائح الألمانيّ آدم اولئاريوس الذي زار إيران في القرن السابع عشر ما شاهده من حمل غرفة زفاف القاسم، والطواف بها خلال حركة مواكب العزاء في شهر محرّم، وكيف أنّ الغرفة زُيِّنت بالورود. وهذه الطقوس تُقام حتى الآن في جنوبيّ إيران ولا سيّما في مدينة بوشهر([343]).
يقوم الإيرانيّون من أهالي قرية كهن آباد التابعة لمدينة كرمسار ـ في محافظة سمنان (التي تبعد 95 كيلومتراً شرقيّ العاصمة طهران) في العشرة الأولى من شهر محرّم كلّ عام خلال إقامة التعازي على الحسين ـ بنصب خيمة صغيرة، وتُحمل على الأيدي، وتغطّى بالقماش الأبيض والأخضر، وتُزيَّن بالورود والمرايا، على أنّها غرفة زفاف القاسم بن الحسن([344]).
ولا تزال طقوس عرس القاسم تُقام في المدن الإيرانيّة ومنها طهران، وترفع مع مواكب اللطم غرفة زفاف القاسم ليلة العاشر من محرّم؛ لإظهار أنّ العريس القاسم بن الحسن استُشهد في كربلاء قبل أن تتمّ إقامة مراسم عرسه. كما أنّ هناك اختلاف بين الكتّاب الذين كتبوا عن عرس القاسم في اسم بنت الحسين التي تزوَّجت القاسم بن الحسن، فمنهم من ذكر أنّ اسمها فاطمة، ومنهم من سمّاها سكينة. فالكاشفي يرى أنّ فاطمة هي زوجة القاسم، ولكنّ تمثيلية مقتل الحسين التي تُمثَّل في مدينة النبطيّة في لبنان تذكر اسم سكينة على أنّها زوجة القاسم. والأمران مختلفان علماً بأنّ فاطمة بنت الإمام الحسين كما يذكر المؤرّخون كانت متزوّجة من الحسن المثنى حين وقعت معركة كربلاء([345]).
منذ القدم يقيم العراقيّون والإيرانيّون مراسم إحياء ذكر الطفل الرضيع ابن الإمام الحسين الذي قتل في كربلاء، عندما رفعه أبوه ليطلب له شربة من الماء، وقد أصابه سهمٌ أنهى حياته، وبهذه المناسبة يصنع العراقيّون والإيرانيّون مهداً يغطّونه بالقماش الأبيض والأخضر، ويرفعونه على الأيدي خلال مراسم العزاء والمواكب التي تخرج بالمناسبة، ويضعون في المهد أطفالاً رضَّعاً؛ تشبّهاً بالطفل الرضيع علي الأصغر، وطلباً للسلامة لأطفالهم. وهذه المراسم معتمَدَة في النبطيّة في لبنان. فلا خلاف بين العلماء والمؤرّخين حول حقيقة مقتل الطفل الرضيع، وكيفيّته.
تُقام في إيران فضلاً عن هذه المراسم، مراسم أخرى في السابع من شهر محرّم، إذ تتجمّع النساء في طهران والمدن الإيرانيّة في مكان تُقام فيه مراسم الطفل الرضيع، حيث تحمل النساء أطفالهنّ الرضّع على أيديهنَّ ويُلبسْنَ الأطفال لباساً أبيض ويلفنَ رأس الأطفال بقماش أخضر؛ تشبّهاً بالطفل الرضيع علي الأصغر، ويقوم قارئ بقراءة أشعار بالمناسبة.وتقام هذه المراسم إحياء لذكرى الطفل الرضيع؛ تيمّناً وتبرّكاً بالطفل، ومشاركة في مراسم العزاء في شهر محرم. يقوم التلفزيون الإيرانيّ بنقل المراسم كلّ عام.
تنقل الروايات الواردة في كتب المقاتل أنّ الحسين بن علي عندما سقط عن ظهر فرسه ذي الجناح يوم عاشوراء، قام هذا الفرس بالدوران حول جسد الحسين، وقد خضّب ناصيته بدم الحسين، وتوجّه نحو خيام أهل بيته؛ ليخبرهم باستشهاده. وتنقل كتب المقاتل روايات عديدة عن فرس الحسين.
ويقول العلّامة محمّد باقر المجلسي في بحار الأنوار: «وأقبل فرس الحسين× وقد عدا من بين أيديهم أن لا يُؤخَذ، فوضع ناصيته في دم الحسين×، ثمّ أقبل يركض نحو خيمة النساء، وهو يصهل ويضرب برأسه الأرض عند الخيمة حتى مات، فلمّا نظرت أخوات الحسين وبناته وأهله إلى الفرس ليس عليه أحد، رفعن أصواتهنَّ بالبكاء والعويل، ووضعت أمّ كلثوم يدها على أمّ رأسها ونادت: وامحمّداه، واجدّاه، وانبيّاه، واأبا القاسماه، واعليّاه، واجعفراه، واحمزتاه، واحسناه، هذا حسين بالعراء، صريع كربلاء، مجزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، ثم غُشي عليها»([346]). وجاء في زيارة الناحية المقدّسة المنسوبة إلى الإمام الحجّة بن الحسن العسكريّ (الإمام الثاني عشر عند الشيعة): «ولما نظرت النساء إلى الجواد مخزيّاً، والسرج عليه ملويّاً، خرجنَ من الخدور ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، وللوجوه سافرات، وبالعويل داعيات»([347]).
صوّر الشاعر ابن حماد فرس الحسين وهو ينوح، ويخبر نساء الحسين وأطفاله باستشهاده ويقول:
|
وراح جوادُ السبطِ نحوَ نسائِه |
وجاء في بعض الأخبار أنّ فرس الإمام الحسين هام على وجهه بعد استشهاد الإمام، وابتعد عن النساء، وألقى بنفسه في نهر الفرات واختفى([349]).
وفي أثناء مواكب العزاء في العراق، يُجرُّ فرس يرمز إلى فرس الحسين ذي الجناح، ويُغطَّى الفرس بقماش أبيض عليه بقع حمراء؛ ترمز إلى الدم، وسهام مثبّتة في القماش تمثّل السهام التي أصابت الفرس خلال المعركة في أرض كربلاء، وهذه الصورة نفسها تتكرّر في النبطيّة يوم التاسع من محرّم.
كما يحدث ذلك في بعض القرى الإيرانيّة، إذ يُخرَج مع مواكب العزاء فرس أبيض يمثّل فرس الحسين، ويُصبَغ ذيله بالأحمر؛ ليرمز إلى الدم، ويُوضَع على ظهر الفرس (جزمة) أو حذاء عالي الساق، إشارة إلى الحرب. كما يُوضَع سيفان على جانبي الفرس، ويقرأ أحد النائحين شعراً بالفارسيّة، هذه ترجمته:
أينَ سيّد الشهداء يا ذا الجناح؟
أين يتامى الحسين يا ذا الجناح؟
فذيلك ملوّن بلون الدم
وروحك حزينة بالموت
ويردّد المشاركون في التعزية: أين سيد الشهداء يا ذا الجناح؟ ([350]).
تُخرَج في الأيام العشرة من شهر محرّم مواكب تمثِّل أشباه أهل البيت ضمن مواكب العزاء التي تخرج في العراق وإيران. ويضمّ موكب أشباه أسرى أهل بيت الحسين عدداً من الجِمال التي تُزيَّن بأقمشة خضراء وسوداء، ويركب عليها عدد من الأطفال والنساء يرمزون إلى أسرى أهل بيت الحسين الذين أسروا بعد استشهاده في كربلاء، ونُقلوا إلى الكوفة، ومنها إلى الشام والمدينة. كما يُوضَع رجلٌ على جمل ويرمز إلى علي بن الحسين زين العابدين الذي كان مريضاً يوم عاشوراء، ولم يتمكّن من خوض المعركة، وأسر مع النساء والأطفال. ولا يزال عرض الشَّبيه كلّ عام في بعض القرى الإيرانيّة وكذلك في مدينة النبطيّة في لبنان في اليوم التاسع من محرّم. وفي كربلاء في العاشر من المحرّم.
عليّ الأكبر هو الابن الأكبر للحسین بن عليّ قُتِل في كربلاء، ويُقام عرض شبيه عليّ الأكبر في قرية كهن آباد الإيرانيّة، حيث يُلبَس عليّ الأكبر لباساً أخضر اللون، وتُوضَع خوذة على رأسه، ويُلبَس كفناً عليه بقع من الدم، ويُركَب فرساً، وفي يده طير أبيض مدمّى الجناحين، ويقرأ أشعاراً بالفارسيّة هذه ترجمتها:
يا طيري الجريح المضمَّخ جناحه بالدما
أنت كهدهد سليمان
اِذهب إلى مدينة جدّنا
أخبر أختنا الصغرى بحالنا.
ويسير شخص في ملابس حمراء ويضع قلنسوة حمراء، وفي يده سيف، ويقرأ الأشعار التالية:
أنا منقذ بن مرّة اللعين
أنا قاتل ابن مَلكِ الدين
أنا قاتل عليّ الأكبر
جئتُ لأثكل الحسين بابنه([351]).
مسلم بن عقيل هو ابن عم الحسين بن عليّ، أرسله مبعوثاً عنه إلى الكوفة ليستطلع أحوال أهل الكوفة، ويخبره بأمرهم، وصل مسلم بن عقيل إلى الكوفة واستقبله الكوفيّون ولكنّهم تخلّوا عنه بفعل ضغوط والي الكوفة عبيد الله بن زياد، وأخيراً أُخِذ مُسلم أسيراً وقُتل. وفي المراسم التي تُقام في الأيام العشرة الأولى من شهر محرّم تُقام طقوس شبيه مسلم بن عقيل، حيث يلبس شبيه مسلم لباسا أخضر اللون، ويضع خوذة على رأسه، ويأخذ ترسا بيده، ويقرأ أبياتاً من الشعر هذه ترجمتها:
يا لها من أيام جميلة يوم مَررتُ من هذا الزقاق
آخذاً بيد طفليَّ الاثنين
أذرفُ الدمعَ على مصير طفليّ
كنت أُمشّط شعرهما وأمشي
وبين الحين والآخر يقرأ مسلم شعراً مخاطباً الحسين بن علي، مشيراً إلى عدم وفاء أهل الكوفة له:
لا تأتِ إلى الكوفة ياسيدي، يا حسين
فالكوفة ليست مكاناً آمناً لك
وعليّ الأكبر لا زال شابَّا ([352]).
لا تزال تُقام في بعض القرى الإيرانيّة طقوس أسر (طفلَي مسلم بن عقيل)، في هذه الطقوس يقوم رجل يمثّل الجلّاد المسمّى الحارث، يأخذ بطرف حبل رُبطَ في طرفه الآخر طفلان يمثّلان ولدَي مسلم بن عقيل، وهما إبراهيم ومحمّد، ويرتدي كلّ من هذين الطفلين، ثوباً أخضرَ اللون ويغطّي قماش أسود رأسيهما، وهما حافيا القدمين، ويسير الحارث بالطفلين ليأخذهما إلى والي الكوفة عبيد الله بن زياد، وبيده عصا يضرب بها الطفلين بين الحين والآخر.
وبين الحين والآخر يقرأ الحارث أبياتاً من الشعر بالفارسيّة ترجمتها كالآتي:
هنيئاً لي وأنا المحظوظ
جاءني الحظّ من حيث لا أدري
أربُط الطفلين بالحبل
لأسلّمهما إلى عبيد الله بن زياد
ويردّد الطفلان الشعر التالي:
عجيب أمرنا نحن اليتامى
نُساق بيد أسيادنا أذلّاء
إلهي لا تحرم الأطفال من الآباء
ولا تترك الأطفال يتامى وأذلّاء
وفي نهاية العرض يأمر الحارث بفصل رأسَي الطفلين، ويرفع المعزّون التابوت الذي وُضع فيه جسدا الطفلين ويدورون به في الميدان، وينتهي العرض. لا تزال هذه العروض تقام في إيران والعراق، خلال مراسم الأيام العشرة الأولى من شهر محرم([353]). ولهذين الطفلين مرقدٌ يقع في غربي مدينة المسيَّب التي تبعد 30 كيلومتراً شماليّ مدينة كربلاء على نهر الفرات، ويزوره محبّو أهل البيت، والمرقد معروف بمرقد طفلي مسلم بن عقيل([354]).
لا تزال مواكب العزاء التي تخرج في العراق وإيران ترافقها التوابيت والهوادج وغرفة صغيرة تُسمَّى غرفة زفاف القاسم بن الحسن مزيّنة بالمرايا والمصابيح والأقمشة الملوّنة، يحملها أشخاص أثناء خروج مواكب العزاء.
وفي إيران تخرج في أيام شهر محرّم مواكب تحمل معها توابيت، تمثّل جنازة الحسين بن علي والشهداء من أبنائه وأهل بيته وأصحابه. وهذه التوابيت أنواع، منها المستطيل والمكعّب، ومنها على شكل الهودج والمحمل، وهناك تابوت يُسمَّى في إيران بـ(النخل) (بسبب استخدام أخشاب النخيل في صنعه)، ويحمله عشرات الأشخاص الأقوياء، ويدار به في ساحة كبيرة، وتُسمّى هذه المراسم بـ(نخل گردانی) [النخل الدوّار] وهذه المراسم تجري فقط في مدينة يزد الإيرانيّة([355]). ولا زالت مواكب العزاء التي تخرج في المدن العراقيّة في شهر محرّم تحمل معها التوابيت وغرفة زفاف القاسم، وهوادج تجلس فيها النساء والأطفال، وترمز إلى أسر أهل بيت الحسين بعد واقعة كربلاء.
درجت العادة أن يحمل بعض المشاركين في مواكب العزاء صور أئمة أهل البيت ولا سيّما صور الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحسين بن علي والعبّاس بن علي× في أثناء التجوّل في الشوارع، أو وضعها إلى جانب الحسينيّة أو داخل المسجد أو التكيّة، وكانت صور الأئمّة قد رُسمت في البداية في إيران ونُقلت إلى العراق.
ولا تزال مواكب العزاء في العراق تحمل صورة رأس الحسين مقطوعاً، مرسوماً على أقمشة أو لوحات قابلة للحمل، وقد منعت الحكومة الإيرانيّة أخيراً حمل الصور المرسومة للحسين والإمام عليّ والعبّاس بن علي مع المواكب، أو وضعها في الحسينيّات أو التكايا. والسبب في ذلك، أنّ الرسّامين لهذه الصور كانوا يتفنّنون في رسم وجوه وعيّون جميلة جداً، وينسبونها إلى أئمّة أهل البيت.
وقد تحدّث (الإمام الخمينيّ) في إحدى خطبه عن حمل صور الأئمّة في مواكب العزاء وعارض ذلك قائلاً: «إنّ استعمال الثناء الفارغ والتافه يكون مضرّاً أحياناً. فمثلاً يتمُّ الحديث حول شخصيّة أبي الفضل العبّاس× (العبّاس بن علي بن أبي طالب)، فيطنب في وصف عينيه وحاجبيه الجميلين، فهل العيون الجميلة نادرة في العالم، وهل كانت قيمة أبي الفضل× مستوحاة من عينيه الجميلتين»([356]).
ازدهرت في القرون الماضية رسوم صور الأئمّة من أهل البيت في إيران، كما قام رسّامون إيرانيّون برسم واقعة كربلاء على القماش، وعرضها في مجالس العزاء وشرح محتواها بواسطة أشخاص تخصّصوا في شرح واقعة كربلاء. سمّيت هذه الرسوم (رسوم المقاهي) كما ذكرنا، نسبة إلى المقاهي التي بدأ الرسّامون الإيرانيّون رسمها فيها وعرضها على روّاد المقاهي التي كانت خلال القرون الماضية تجمع الناس ولا سيّما العمّال والفنانين والمثقّفين. كانت رسوم الأئمّة وواقعة عاشوراء تُرسَم على الأقمشة والجدران والزجاج والخشب والسراميك والقاشاني، ولكن من أشهرها الرسوم على الأقمشة، التي كانت سهلة النقل من مكان إلى آخر.
كانت الرسوم تتضمن موضوعات عديدة، منها وقائع يوم عاشوراء واستشهاد الحسين، وساحة القتال بين الحسين وأصحابه وجيش بني اُميّة، وأسرى أهل البيت في الكوفة والشام، وصورة الإمام الحسين والإمام عليّ والرسول محمّد|، وحروب الرسول| وحروب الإمام عليّ×، وصور الإمام الثامن عند الشيعة علي بن موسي الرضا المدفون في خراسان. وصور النبي يوسف وإخوانه وأبيه يعقوب، وقصته مع زليخا. كما تضمَّنت رسوم المقاهي قصص أبطال إيران التاريخيّين ومنهم سهراب ورستم، ومقتل سهراب على يد رستم، والحروب التي دارت قديماً بين الأبطال الإيرانيّين حيث حفل كتاب (الشاهنامه) للشاعر الإيرانيّ إبي القاسم الفردوسي بقصص أبطال إيران. وإستلهم الرسّامون من أشعار الفردوسي الحماسيّة، ورسموا صور الأبطال الأسطوريّين. توقّف عرض رسوم المقاهي بعد وفاة أهمّ الرسّامين الإيرانيّين المعروفين ومنهم: محمّد مدبّر وحسين قوللر آغاسي، وحسن إسماعيل زاده، ولا زالت رسوم هؤلاء الرسّامين تُعرض في متاحف إيران.
السير على الأقدام بمناسبة أربعينيّة الحسين
منذ سنوات يقوم العراقيّون بالسير مشياً على الأقدام إلى مدینة كربلاء المقدسة بمناسبة أربعينيّة الإمام الحسين، التي تصادف العشرين من صفر من كلّ عام. ويشارك في هذه الطقوس ملايين الأشخاص الذين يأتون من مختلف المدن العراقيّة، ومن دول الجوار العراقيّ، ولا سيّما دول الخليج وإيران وحتّى من الهند والباكستان، والمدن الآسيويّة والأفريقيّة، والجاليات العربيّة في أوروبا.كما يشارك في هذه الطقوس، إضافة إلى الشيعة، أهل السنّة والمسيحيّون والصابئة.
توسَّعت هذه الطقوس كثيراً في السنوات الأخيرة، وبات العراقيّون يسيرون من مدنهم في الشمال والجنوب والشرق والغرب مشياً على الأقدام؛ ليصلوا إلى مدينة كربلاء لزيارة مرقد الإمام الحسين.
تُقام في الطرق التي تربط المدن العراقية بمدينة كربلاء خيم وسُرادقات على طول الطريق، حيث المبيت والطعام والشراب وسائر الخدمات التي يحتاج إليها الزوار، لا سيّما أماكن النوم والاستراحة. يُخصِّص العراقيّون من مختلف الطبقات أموالاً طائلة لإنفاقها على خدمة الزوّار الذين تصل أعدادهم بحسب الإحصاءات إلى ملايين الأشخاص رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً.
ويقطع العديد من الأشخاص عشرات الكيلومترات مشياً على الأقدام للوصول إلى مدينة كربلاء بحيث تكتظُّ المدينة، ويقوم البعض من العراقيّين بالمشي سيراً على الأقدام من أقصى جنوب العراق، أي مسافة حوالى 500 كيلومتر من البصرة حتّى مدينةكربلاء. فالكلُّ يمشي إلى كربلاء حبّاً بالحسين، ليثبت أنّه يسير على طريقه. وعلى الرغم من تعرّض الزوّار لعمليّات إرهابيّة خلال السنوات الماضية، تنفّذها الجماعات المتشدّدة، ويُقتل العديد من الزوار في مختلف المدن العراقيّة، إلّا أنّ هذه المسيرات تزداد سنة بعد أخرى، ويزداد عدد الزوار باضطراد كلّ عام.
طقوس عاشورائيّة انقرضت أو في طريقها إلى الزوال
إنّ العديد من الطقوس العاشورائيّة التي كانت موجودة قبل نصف قرن أخذت بالزوال بصورة تدريجيّة؛ نظراً لتغيّر الظروف والأحوال، ولكنَّ بعض الطقوس بقيت كما كانت في ذلك الوقت، وتعزّزت طقوس أخرى؛ نظراً لبروز عوامل جديدة.
فدخول التلفزيون إلى البيوت، واستخدام الإنترنت على نطاق واسع، جعل كثیراً من الناس يجلسون في بيوتهم وينظرون إلى برامج التلفزيون ويشاهدون الطقوس العاشورائيّة في بیوتهم، لا سيّما وأن التلفزيون أخذ يبثّ الطقوس العاشورائيّة من مصادرها، أو أنّ الأقراص المدمجة أخذت مكانها في بيوت المواطنين، وسهّلت عليهم مشاهدة العروض العاشورائيّة، أو الاستماع إلى الخطباء والنائحين على الحسين×.
يرى أحد المهتمّين بدراسة الطقوس العاشورائيّة أنّ أحد العوامل التي تهدّد بإضعاف هذه الطقوس هو استخدام الموسيقى الحديثة في الطقوس العاشورائيّة، وزوال الموسيقى التقليديّة المستخدمة في عروض التعازي والنواح والتشابيه في السنين الماضية، ويحذّر من أنّ استمرّار استخدام الموسيقى الحديثة سيكون عاملاً في زوال العروض العاشورائيّة التي تُعدّ جزءاً من التراث الثقافيّ الإيرانيّ، وسبباً في نسيانها ([357]).
من ضمن العروض التي كانت رائجة في العراق وانقرضت الآن عرض شبيه الأسد، يمثّله رجل يرتدي جلد أسد، ويجلس على محفّة خشبية يحملها الرجال على عواتقهم ويسيرون بها في موكب العزاء. ويرمز شبيه الأسد إلى حزن الحيوان على مقتل الحسين، ويقوم شبيه الأسد بنثر التبن على رؤوس المعزّين في إشارة إلى الحزن على استشهاد الحسين. كما أنّه يرفع يداً من الجلد ترمز إلى يد العبّاس بن علي التي قُطعت في معركة كربلاء. وكانت هذه العروض تُقام في كربلاء في الستينات من القرن الماضي حيث شاهدها الباحث هناك. ويُقام عرض شبيه الأسد حاليّاً في قرية كهن آباد التابعة لمدينة غرمسار في محافظة سمنان (شرقيّ طهران).
في طهران القديمة كانت تُقام مراسم تُعلّق فيها الأقفال على الأبدان، وهذه الطقوس نُسخت ولم تعد موجودة الآن؛ بسبب معارضة المراجع وعلماء الدين لهذه الطقوس([358])، وقد عارض الإمام الخميني مثل هذه الطقوس قائلاً: «لقد جرت العادة قديماً بين عوام الناس أن يعلّقوا أقفالا بأجسامهم في مراسم العزاء، فانبرى لها كبار العلماء واندثرت هذه العادة، غير أنّها ظهرت مجدّداً في الآونة الأخيرة، وسمعتُ أنّ البعض يعلّقون الأقفال بأجسامهم في مواكب العزاء. إنه عمل خاطئ يقوم به البعض، وكذلك الأمر بالنسبة لشجّ الرؤوس بالسيوف أي ما يُصطلح عليه بـ(التطبير)، الذي يُعدُّ مخالفاً هو الآخر»([359]).
هناك طقوس أخرى تُجرى في أيام شهر محرّم في بعض القرى الإيرانيّة ولا زالت، نذكر منها مراسم (سنگ زنی) أي (ضرب الأحجار) وهذه المراسم تُقام في قرى العديد من المناطق الإيرانيّة، ويعود تاريخها إلى مائة عام.
یقوم شباب بعض القرى في شهر محرّم بتشكيل حلقة يحمل كلّ منهم حجراً في كلتَي يديه أو خشبة في يديه بدلاً من الحجر، وعندما تبدأ المراسم يقوم نائح بقراءة الشعر في رثاء الحسين، ويبدأ المشاركون بضرب الحجرين أو الخشبتين ببعضهما وبصورة منسّقة مع الشعر.
يقول بعض الشيوخ من كبار السن أنّ هذا الطقس يُقام منذ حوالى مائة عام، ويرمز إلى حزن شيعة الحسين عليه، لأنّه ذُبح في كربلاء والبعض منهم يضرب الحجر برأسه أو على صدره حزناً على الحسين. وحيث إنّ هذه الطقوس تُقام في كلّ عام في قرية (صد خرو) الواقعة بين مدينة داورزن وسبزوار (شمال شرقيّ إيران ويعكف أهالي القرى على إقامتها كلّ عام، فقد تمّ تسجيل مراسم (سنگ زنى) [ضرب الأحجار] كتراث ثقافيّ إيرانيّ في منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)([360]).
كما أنّ طقوساً أخرى كانت تُسمَّى چاوشی خوانی قد انقرضت. هذه الطقوس كانت تُقام لمن كان يزمع السفر إلى حج بيت الله الحرام أو السفر إلى العتبات المقدّسة في العراق. فكان شخص يسير في موكب المسافر إلى الحج أو إلى كربلاء ويقرأ دعاءً؛ ليخبر به أهالي المدينة أو البلدة بسفر الشخص إلى الحج أو كربلاء أو رجوعه منهما. وكان الشخص يحمل راية نُقشت عليها صورة الكعبة أو قبّة ومنارة مرقد الإمام الحسين. وأشار عدد من الرحّالة أو السيّاح الذين زاروا إيران إلى هذه الطقوس ومنهم ابن بطوطة في رحلته إلى إيران، والسائح جون أورتر في مدوّنة رحلته([361]).
الباب الثاني
الفصل الأوّل: متى بدأت عروض التعزية في إيران؟
الفصل الثاني: دراسة مقارنة لثلاث مسرحيّات عاشورائيّة
الفصل الثالث: نظرة إلى مسرحيّة تعزية عرس القاسم
الفصل الاول
متى بدأت عروض التعزية في إيران؟
حداث واقعة كربلاء([362]).
فالشَّبيه الصامت تعود جذوره إلى القرن الرابع الهجريّ، عندما كان البويهيّون يعرضون مظالم الخلفاء وواقعة كربلاء على شكل شبيه، ولكنّ عروض الشبيه كانت آنذاك صامتة، وكان الممثّلون يلبسون ملابس ملوّنة، ويركبون الخيول وبعضهم يكون راجلاً. ثمّ تحوّل الشَّبيه في ما بعد إلى شبيه ناطق يقرأ الشعر الذي هو لغة التعزية عند الإيرانيّين([363]).
ظهر الشَّبيه الناطق في عصر ناصر الدين شاه القاجاريّ (1264ـ 1314هـ/1848 ـ 1897م) أو وصل في عهده إلى حدّ الكمال. وبرز العديد من الممثّلين في عروض الشَّبيه منهم الملّا حسين إمامخان، وميرزا غلام حسين عبّاسخوان وجهانغير مسلمانخوان([364]).
يختلف الباحثون الإيرانيّون حول زمان إقامة عروض التعزية على المسرح في إيران([365]). فمنهم من يرى بأنّ مسرح التعزية بدأ في العصر الصفويّ (907 ـ 1135هـ) ومنهم من يعتقد بأنّ هذا المسرح بدأ بعد العصر الصفويّ، أي في عصر الحاكم الإيرانيّ كريم خان زند (1164 ـ 1193هـ) ويرى آخرون بأنّ عروض التعزية بدأت في العصر القاجاريّ (1210 ـ 1344هـ).
«يرى الباحث الإيرانيّ محمّد جعفر محجوب أنّ نتائج دراساته وبحوثه التي استمرّت لسنين طويلة حول مسرح التعزية تفيد أنّ مسرح التعزية لم يبدأ في العصر الصفويّ (907 ـ 1135هـ)، على الرغم ممّا كتبه السيّاح الغربيّون، ولا سيّما السائح الفرنسيّ شاردن عن إقامة مراسم العزاء، وخروج مواكب العزاء في مدينة إصفهان في العام 1697م([366]). لكنَّ كاتباً إيرانيّاً آخر هو نصر الله فلسفي يعتقد أنّ مسرح التعزية بدأ في عصر كريم خان زند (1164 ـ 1193هـ) ويقول: في عصر كريم خان زند جاء سفير أوروبيّ إلى إيران ووصف للشاه المسرح الدراميّ الذي كان يُقام في الغرب، وبعد أن استمع كريم خان إلى أقوال السفير أمر بإقامة عرض مسرحيّ لوقائع كربلاء ولمقتل 72 من أصحاب الإمام الحسين، وقد أقاموا عروضاً دينيّة عُرفت في ما بعد بالتعزية([367]).
ويشير المسرحيّ الإيرانيّ بهرام بيضائي إلى أنّ مسرح التعزية تشكّل أواخر الحكم الزنديّ (1164 ـ 1203هـ)، وتطوّر في بداية العصر القاجاريّ بسبب دعم الملوك وطبقة جديدة من التجّار والسياسيّين له. فهذا الدعم لم يكن دعماً للمسرح، بل كان أداةً ووسيلة لكسب الوجاهة الوطنيّة. كانت المسرحيّات تُقام في الميادين والمقابر وفي أماكن العرض المؤقّتة، التي كانت تسمّى (التكيّة) أو (الحسينيّة). وكانت العروض تُقام في خيم كبيرة جدّاً، تُقام على دعائم خشبيّة، وكانت هذه الخيم تُقام بسهولة، وتُجمع وتُنقل إلى مكان آخر. بعد مدّة أُقيمت أماكن للعرض ثابتة أقامها رجال الدولة آنذاك، وكانت هذه الأماكن لها ارتباط تشبه المباني التقليديّة المسماة (زورخانه) (الأماكن التي كانت تقام فيها الرياضة التقليديّة). وكانت تُقام في وسطها مصطبة يتخذها الممثّلون مكاناً للتمثيل. كما كانت تُخصَّص غرف يجلس فيها المشاهدون. تمّ بناء أحد هذه المباني المسمّاة التكية (تكية نوروزخان) العام 1177ش [1798م] في طهران، وصادف ذلك السنوات الأولى من حكومة فتحعليشاه القاجاريّ»([368]).
أمّا الكاتب الإيرانيّ برويز ممنون فإنّه يرفض القول بأنّ مسرح التعزية وُجد في عهد كريم خان زند، ويعلّل كلامه بأنَّ الزنديّين حكموا إيران لمدّة قصيرة فلا يمكن أن یكون مسرح التعزية قد أُقيم في عهدهم، كما أنّه لا يرى بأنّ مسرح التعزية بدأ في عصر الأفشاريّين (1148 ـ 1210هـ) الذين سبقوا الزنديّين، ويستدلّ على ذلك بالقول إنَّ القائد العسكريّ نادر شاه أفشار (1148 ـ 1160هـ)([369]) مَنعَ إحياء عاشوراء وإقامة مراسم العزاء في هذا الشهر، وأصدر الأمر التالي: «كلّ من يتحدّث عن إقامة المآتم والعزاء بين خدمي وجنودي فسأقطع لسانه»([370]). وكان سبب إصدار الأمر أنّ مراسم العزاء في عاشوراء أثارت الخلاف بين شيعة إيران والعثمانيّين في عهد الدولة الصفويّة؛ لذلك منع نادر شاه إقامة العزاء للحدّ من الخلافات بين الشيعة والسنة. يعتقد برويز ممنون أنّ مسرح التعزية كان قد بدأ قبل العصر الأفشاريّ، وهذا ما يشير إلى أنّ التعزية تعود جذورها إلى العصر الصفويّ. يستدلُّ ممنون على ما يقوله بأنَّ (تعزية القاسم) تدلّ على أنّها وصلتنا بعد اكتمال تعزية (استشهاد الحسين) ولهذا يجب أن تكون التعزية قد مرّت بمرحلة طويلة قبل أن تصلنا بشكلها الحاليّ([371]). ويرى ممنون أنّ الصفويّين أظهروا رغبتهم في إقامة المراسم الدينيّة بين الشيعة لرصّ الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنيّة حيث أشاعوا مراسم العزاء في شهري محرّم وصفر، وكانت المواكب تخرج بصورة منتظمة، وكانت هذه المراسم تتعزّز سنة بعد أخرى، وفي عصر الشاه عبّاس الصفويّ (996 ـ 1038هـ) ظهر الشَّبيه الذي يقوم بدور شخصيّات واقعة كربلاء، ومنها شبيه عليٍّ الأكبر والعبّاس، وعرس القاسم وأسرى كربلاء وخروج النساء والأطفال، ويبدو أنّ خروج مواكب العزاء بهذا الشكل كان خلال حكم الشاه سلطان حسين الصفويّ (1105 ـ 1135هـ) أو بعد مدّة قصيرة من حكمه.
إنّ ما قاله المخرج الإيرانيّ بهرام بيضائي بأنّ مسرح التعزية تشكّل أواخر الحكم الزنديّ (1164 ـ 1203هـ)، وتطوّر في بداية العصر القاجاريّ بسبب دعم الملوك وطبقة جديدة من التجّار والسياسيّين له، هو الأقرب إلى الواقع، وأنّ التعزية وصلت إلى الكمال في العهد القاجاريّ، وهذا ما استدعى بناء تكيّة دولت في عهد ناصر الدين شاه القاجاريّ (1264 ـ 1314هـ) من أجل إقامة التعزية فيها.
بناء التكايا لإقامة عروض التعزية في إيران
تستخدم كلمة (تكيّة) وجمعها (تكايا) في اللغات العربيّة والفارسيّة والتركيّة؛ ويرجع البعض أصلها إلى الفعل العربيّ (اِتّكأ) بمعنى استند أو اعتمد، وهي مكان إقامة الصوفيّة. واتكأ في اللغة العربيّة بمعنى جلس متمكّناً، أو جلس وأسند ظهره أو جنبه إلى شيء. وأتْكأ فلاناً أي أجْلسَهُ ومَكّنَهُ في مجلسه([372]). معنى تكيّة في معجم معين الفارسيّ: «الاتكاء على شيء، ومكان إيواء الفقراء، والمكان الذي تُقام فيه مراسم العزاء على الحسين»([373]).
جاء في كتاب «تاريخ خانقاه در إيران» [تاریخ الخانقاه في إيران]([374]) تعريف التكيّة بأنّها كلمة عربيّة من وكأ أي اِتكأ على شيء وتعني أيضاً متّكأ، وكلمة تكيّة عند الصوفيّين بمعنى الخانقاه ومنزل الدراويش، والمكان الذي يُقدّم فيه الطعام للدراويش والفقراء. فقد ظهرت هذه الكلمة بداية في الدولة العثمانيّة، واستُعملت بعدها في مناطق أخرى)([375]).
أشار المستشرق البريطانيّ إدوارد براون إلى أنّ كلمة تكيّة دخلت في اللغة التركيّة والفارسيّة وعند الشعب السوريّ بعد هجوم العثمانيّين على الدولة البيزنطيّة سنة 1353م، وتعني الكلمة الرباط وخانقاه ([376]).
جاء في (دائرة المعارف الفارسيّة): تُعرَّف التكيّة بأنّها محلّ يتمّ فيه شرح مصائب الإمام الحسين× على شكل تعزية ومجلس عزاء. وهو عبارة عن مكان محصور وفي وسطه مصطبة مستديرة الشكل، أو مربّعة وتقوم مقام المنصّة. وفي أطراف المصطبة غرف وأواوين يجلس فيها رجال الدولة من أجل مشاهدة مراسم التعزية([377]).
يرى الكاتب الإيرانيّ محمّد جعفر محجوب بأنّ التكيّة كانت موجودة قبل قرون من إقامة التعزية عند الشيعة، مضيفاً أنّ التكيّة كانت موجودة في البلدان التي تُعِدّ التعزية كفراً وإلحاداً مثل الباكستان. فالتكيّة كانت موجودة في الأراضي التي لم يكن فيها وجود للشيعة، بل كانت تُقام فيها مجالس الصوفيّة. كما كانت موجودة في شبه القارّة الهنديّة وباكستان([378]). التكایا التي كانت في الأساس خاصّة بالمتصوّفة استُخدِمت لإقامة مجالس العزاء، مع الأخذ في الحسبان العلاقة العاطفيّة التي تربط المتصوّفة بأهل البيت.
ومثلما كان الناس في العصر القاجاريّ يبدون تلهفّاً لإقامة مجالس العزاء ومراسم التعزية في التكايا، فإنّهم كانوا يحرصون أيضاً على بناء التكايا، فالذين كانوا يبنون التكايا كانوا يقصدون من ورائها الحصول على الثواب في الدنيا والآخرة، كما كان البعض يخصّص أوقافاً لها، وكان البعض يريد بذلك كسب الشهرة بين الأقارب والأصحاب والخلّان([379]). ففي العصر القاجاريّ، بُنيت تكايا كثيرة بناها الملوك والوزراء، ورجال الحكومة والأشراف والأعيان، والناس العاديّين، وأصحاب الحرف في الأحياء والحارات، لإقامة مجالس العزاء علی سيّد الشهداء في الأيام العشرة الأولى من شهر محرَّم([380]).
وطبقاً لإحصاء أصدرته دار الخلافة في طهران سنة 1269هـ/1847م أي في السنوات الأولى من حكم ناصر الدين شاه القاجاريّ (1264 ـ 1314هـ /1848 ـ 1897م)، فإنَّ طهران كانت تضمّ 54 تكيّة، كانت ثلاث منها تابعة للحكومة والبقيّة غير حكومية موزّعة على مختلف أحياء طهران([381]).
(تكية دولت) هي أكبر تكيّة بنيت في طهران، إذ أصدر ناصر الدين شاه القاجاريّ (1831 ـ 1896م) أمراً إلى وزیر الخزانة دوست علي خان معير الممالك ببنائها، وقد أنجز ذلك سنة 1290هـ/1873م([382]) وكانت هذه التكيّة من أحسن التكايا في القرن التاسع عشر. فقد شاهدت الليدي شيل زوجة جستين شيل سفير بريطانيا في عهد نادرشاه العام 1894 تكيه دولت، ووصفتها بأنّها أكبر تكيّة في طهران، وتتسع لعدّة آلاف من الأشخاص.
ويقول الكاتب ساموئيل بيترسون بأنّ ناصر الدين شاه القاجاريّ عندما سافر إلى لندن في العام 1873م دُعِيَ إلى مشاهدة أوركسترا في مبنى (ألبرت هال) وتأثّر بما رأى هناك، وعندما عاد إلى طهران أمر ببناء مبنى يشبه مبنى ألبرت هال، وتمّ بناء (تكية دولت) إلى جانب قصر غلستان، ليُقام فيها مسرح التعزية([383]). وينقل عن أحد السيّاح الأجانب قوله بأنّ تكيّة دولت لم تكن تشبه مبنى ألبرت هال، وقد بُنيت على شكل مدوَّر وعلى الطراز القاجاريّ([384]) ولم يذكر بيترسون المصدر الذي استقى منه هذه المعلومة، ويبدو أنّه أراد أن يوحي إلى المتلقّي بأنّ مسرح التعزية مأخوذ من الغربيّين، وأنّ تكية دولت وهي التكيّة الرئيسيّة في طهران جاء بناؤها بوحي من الغربيّين، وعلى غرار مباني المسرح الأوروبيّ. ولكن بترسون لم يذكر الفرق بين تكيّة دولت ومبنى ألبرت هال، لأنّ التكايا في إيران لم تشبه مباني المسارح العالميّة؛ لأنّها كانت تحتوي على مصاطب في وسط التكيّة لإقامة عروض التعزية، بينما مباني المسارح العالميّة تخلو من المصاطب والعروض المسرحيّة كانت تقام على خشبة المسرح الذي يُبنى في القسم الإماميّ من مبنى المسرح في جميع أنحاء العالم. ومن هنا يمكننا أن نقول بأنّ التكايا في إيران بُنيت طبقاً للهندسة المعماريّة الإيرانيّة، ولم تأخذ شكلها من العمارة الأوروبيّة. وسوف نرى الفرق بين التكايا في إيران ومباني المسارح العالميّة في الفقرة التالية التي تُفنِّد مزاعم بيترسون.
كانت (تكية دولت) عبارة عن مبنی مدوّر الشكل في وسطه مصطبة، يقوم الممثّلون بأداء أدوارهم، ويجلس المشاهدون على كراسي تتّسع لألفين إلى ثلاثة آلاف شخص يجلسون على شكل هلال؛ لمشاهدة عروض التعزية. وكانت (تكیه دولت) تقع في منطقة سبز ميدان، جنوب غرب شمس العمارة وسط طهران. وكانت تُقام فيها مراسم ومجالس التعزية لسنوات طويلة، وتمّ هدم المبنى سنة 1327هـ.ش [1948م] في عهد رضا شاه الذي منع إقامة العزاء وعروض التعزية. وبُني مكان التكيّة مبنی البنك الوطنيّ الحاليّ الذي يقع في منطقة البازار الكبير([385]).
في تقريره عن التكايا في طهران، كتب الكونت دوكوبينو ـ خلال إقامته في طهران بين العام 1855 و1863م ـ ويقول: «في كلِّ حارة في طهران يوجد تكيّة، وحيث لم تخصّص لها أيّة ميزانيّة حكوميّة فإنّ عدداً من الوزراء والملك كانوا يشجّعون على إقامتها». شُیّدت التكايا ابتداءً من سنة 1840م، وفي سنة 1928 أي في عصر رضا شاه وضعت قيود على إقامة التعزية، ومُنعت مراسم التعزية منعاً باتّاً في سنة 1935م([386]).
تُقام حاليّاً مراسم العزاء في الحسينيّات التي حلّت محلّ التكايا في العاصمة طهران والمدن الإيرانيّة، وقلّما نجد في إيران حاليّاً تكايا تُقام فيها مراسم العزاء.
يبدو أنّ مسرح التعزية في إيران لم يكن متكاملاً، بل تدرّجَ إلى الكمال بعد سنوات من العمل الدؤوب، وكانت هناك عوامل عديدة ساعدت على اكتمال مسرح التعزية في إيران، منها دعم البلاط الإيرانيّ ولا سيما البلاط القاجاريّ، والدور الذي أبداه كتّاب المسرح في الارتقاء بالنصوص، وكذلك جهود عدد من المسؤولين في مختلف العصور لإعادة النظر في النصوص الضعيفة نظراً لما للتعزية من مكانة عند الإيرانيّين.
لم نجد خلال دراستنا لعروض التعزية في إيران مصادر إيرانية تتحدَّث عن عروض التعزية في إيران إلا نادراً، فقد تحدَّث الكاتب الإيراني عبد الله مستوفي عن عروض التعزية في العصر القاجاري بصورة مختصرة في كتابه (شرح زندگانی من) تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجاریه (سیرة حیاتی) التاريخ الاجتماعي والاداري في العصر القاجاري كما أشار الكاتب الإيراني اسكندر بيك منشي في كتابه تاريخ عالم اراي عباسي تاريخ العالم في عصر الشاه عباس الصفوي إلى عروض التعزية في العصر الصفوي.
ولا يمكن أن ينكر الباحث دور السيّاح الأوروبيّين والسفراء ومبعوثي الدول الأوروبيّة إلى البلاط الإيرانيّ في نقل ما شاهدوه من عروض التعزية خلال القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، ووصف هذه العروض وصفاً دقيقاً، بحيث بقيت كوثائق في التاريخ على شكل مذكّرات، وتقارير وكتب طُبعت في أوروبا، وتُرجمت إلى اللغات الأخرى ومنها الفارسيّة. لولا التقارير والمذكّرات والكتب التي وضعها السيّاح والدبلوماسيّون الأوروبيّون الذين زاروا إيران وشاهدوا مسرح التعزية خلال عدّة قرون، لما عرف الإيرانيّون وغيرهم مسرح التعزية على حقيقته.
دوَّن الدبلوماسيّون والسيّاح الأوروبيّون ـ الذين تواجدوا في إيران في عصر الملوك الصفويّين والقاجاريّين في القرن السابع عشر وما بعده ـ مشاهداتهم عن إقامة عروض التعزية في التكايا والميادين والساحات العامّة في طهران والمدن الإيرانيّة. وشهادات السيّاح والدبلوماسيّين الأوروبيّين عن التعزية موثّقة ومدوّنة في الكتب والوثائق الموجودة في المتاحف الأوروبيّة. زار اثنان من السيّاح الهولنديّين وهما سالامونز Salamon ووان كوخ Van Goch إيران سنة 1739، وقدّما وصفاً للعروض الدينيّة، وكتبا يقولان: «كان الإيرانيّون يقيمون أثناء مراسم العزاء الشَّبيه للحروب التي خاضها الحسين وأهل بيته على متن عربات كبيرة وصغيرة، أثناء تحركها، وهو أوّل إشارة عن إقامة عرض مسرحيّ للتعزية في إيران»([387]).
أشار صموئيل هملين (Samuel Hmelin) الذي زار شمال إيران بين العامين 1770و1772م إلى إقامة التعزية في تكيّة في مدينة رشت، عُرضت فيها مشاهد حيّة عن فاجعة كربلاء([388]).
شرح وليم فرانكلين مشاهداته في سفره من البنغال إلى إيران بين 1786 ـ 1787م عن كيفيّة تحويل مراسم عاشوراء إلى عرض مسرحيّ للتعزية. وأشار إلى أنَّ مسرح التعزية كان يُقام خلال الأيّام العشرة الأولى من شهر محرّم، وكان الإيرانيّون يعرضون في كلّ يوم مسرحيّة تمثّل إحدى وقائع عاشوراء([389]).
وأشار فرانكلين إلى عرض مسرحيّة (عرس القاسم بن الحسن) على ابنة عمِّه فاطمة بنت الحسين، على المسرح، وكان يؤدّي دور العروس طفلٌ يلبس ملابس فتاة، ويتجمّع حولهما النساء، وهنَّ يلطمن ويقرأن المراثي خلال مراسم العرس والزفاف. علماً بأنّ القاسم قد قُتل خلال المعارك في كربلاء. وطُبع كتاب وليم فرانكلين للمرّة الأولى العام 1788م في كلكتة الهنديّة، وطُبع في لندن سنة 1790م وطُبع في العام 1798م في باريس بعنوان (رحلة من البنغال إلى شيراز)([390]).
يرى أوّل سفير للولايات المتحدة في إيران وهو س.ج، بنيامين (1882 ـ 1885م) بأنّ التعزية بشكلها الحاليّ (أي في العصر القاجاريّ) وصلت إلى ما وصلت إليه نتيجة تطوّر وتحوّل عبر سنين، ولم تكن متطوّرة بوضعها الحاليّ. ولكنّ تساؤل الباحثين يدور حول بداية إقامة عروض التعزية في إيران؛ أي إقامة التعزية على شكل عرض على المسرح وبصورة متكاملة([391]). تحدّث الكاتب الامريكيّ مفصّلاً عن تكيّة دولت في كتابه (رحلة إيران والإيرانيّين) الذي طُبع في لندن سنة 1886م.
لم يكن بنيامين دبلوماسيّاً فقط، بل كان كاتباً لعدّة كتب عن الفنّ في أوروبا والولايات المتحدة.
زار الكساندر خوجكو أو خودزكو Alxandr Edmond chodzko([392]) إيران في العام 1830م وشاهد مسرح التعزية وتأثّر به كثيراً. واشترى نسخ 33 مجلس تعزية من منتج مجالس التعزية في البلاط الملكيّ آنذاك. وهذه النسخ المحفوظة تُعدّ أفضل الوثائق دلالة على تطوّر مجالس التعزية. فقد قام خوجكو بإيداع هذه النسخ في المكتبة الوطنيّة في باريس، ونشر مجلسين من مجموع 33 مجلساً بالفارسيّة سنة 1852م بعنوان (جُنگ شهادت) [دفتر الشهادة] في إيران. وكتب خوجكو عن التعزية ما يلي:
«الإيرانيّون أصحاب فنون دراميّة ومسرحيّة وأدبيّة، وهذا ما يعجب المستشرقين. لم أر أحداً غيري من العلماء والسيّاح المهتمين بالشرق وما يتعلّق به، من يبحث عن هذا الواقع الأدبيّ الجميل. لقد سجّل العديد من السيّاح الذين أُتيحت لهم الفرصة لمشاهدة مراسم عزاء شهر محرّم ومسرح التعزية، ولكنَّ هذه الكتابات كانت غامضة ومبهمة، وبقيت الدراما الإيرانيّة بعيدة عن أعين المستشرقين. فالسيّاح الأوروبيّون لهم تصوّرات مسبقة عن فنّ الدراما وما يتعلّق به. فالسائح الأوروبيّ يعتقد أنّ الفنّ الدراميّ كان في البداية على شكل مسرح، أي بني بشكل خاصّ على غرار مسارح باريس أو نابولي، ولكن بطابق أرضي وخُصّصت شرفة (للمشاهدين)، وغرفة خاصّة لتجمع الفنّانين. ولا يوجد مثل هذا البناء في أيّ من المدن الإيرانيّة بمثل هذه الهندسة المعماريّة (الأوروبيّة)، ولا يُذكَر شيء عن وجود مبنى مماثل، والأرجح عدم وجود مسرح للعرض. فالإيرانيّون لدیهم العنصر الأساسيّ في المسرح ألا وهو النصّ الدراميّ المنظوم. إنَّ ما لدى الإيرانيّين من أدوات تختلف اختلافاً كاملاً عمّا لدينا. لذلك يجب أخذ المسرح الدينيّ الإيرانيّ على محمل الجدّ»([393]).
أقام الكونت دو كوبينو حقبةً في إيران، وعدَّ مسرح التعزية من أكبر الوقائع في إيران، ونشر كتابه بعنوان (الأديان والمعتقدات الدينيّة في آسيا الوسطى)، طُبع في باريس العام 1865 و1957م وأثرّ كثيراً في أعمال الباحثين والأدباء الأوروبيّين. وفي كتابه تحدّث الكونت دو كوبينو عن الدراما والمسرح في إيران، وقدّم ترجمة لـ(عرس القاسم) من دون أن يشير إلى النصّ الأساسيّ الذي ترجمه. وعن مسرح التعزية يقول: «لا لذّة أكبر من لذّة مشاهدة مثل هذه المسرحيّات مقارنة بالمسرحيّات الدينيّة. فالرغبة الجامحة موجودة عند جميع الأفراد رجالاً ونساء وأطفالاً، حيث يشعرون بشعور قوّي، وعندما يقام المسرح يذهب أهالي المدينة لمشاهدته. ففي كلّ ساحة وميدان ومحلّة أُقيمت مِظلَّة لتقي الناس حرارة الشمس. يقف الممثّلون تحت المظلات، ولكنّ التمثيل يجري أمام أعين المشاهدين في وسط الميدان. يقف الرجال في جانب والنساء في جانب آخر من الميدان، وقصّة المسرحيّة تكون دائماً محزنة اقتُبست من حياة الإيرانيّين، مثل مقتل البرامكة على أيدي الخلفاء العبّاسيّين»([394]).
«أشهر المسرحيّات التي تُمثَّل في شهر محرّم يكون موضوعها هو (مقتل الحسين بن علي وأفراد أسرته في صحراء كربلاء). فهذا المسرح يسمّى (تعزية). ويستغرق عشرة أيام ويُمثَّل كلّ يوم بين ثلاث وأربع ساعات. فالأشعار التي تُقرأ جميلة جدّاً وتُقرَأ بصورة شجيّة وحزينة. فلا ضير من طول مدّة التعزية؛ لأنّ الإيرانيّين لا يملّون سماع تفاصيل المصائب، وما تحمّله أهل البيت من عذاب وآلام وقتل. فالناس يبكون من شدّة الحزن على أهل البيت، ويصرخون ويحزنون جرّاء ما لقيه الحسين وأصحابه. فكثير من الناس يرى هذه المصائب حقيقيّة، فلا يمكن لهم سماع التعزية من دون أن يذرفوا الدموع. لقد رأيت الأوروبيّين يحزنون أيضاً لهذا المصاب»([395]).
یصف الكونت دو كوبینو مشاهد تعزیة الإمام الحسین بقوله: «يعتلي عالم دين المنبرَ ويتحدّث عن مصائب أهل البيت، ويشرح ما تحمّلوه من عذاب، ويلعن الحكّام الظالمين، وترى النساء يلطمنَ صدورهّن، ويصرخنَ وينادينَ يا حسين يا حسين، وبعد وقت قصير، يبدأ العزاء. ويقوم ممثّلون بتأدية دور الأشرار، وهؤلاء لا يتمالكون أنفسهم، ويجهشون بالبكاء؛ لأنَّ المشاهدين يظنّون بأنّ هؤلاء هم الشرّيرون. وقد رأيت أحدهم كان يمثّل دور الخليفة الأمويّ يزيد بن معاوية، وكان يكره نفسه عندما كان يهدّد الأخيار، ويجهش بالبكاء، ولا يقدر على الكلام إلّا بصعوبة، وهذا ما كان يُحزن المشاهدين»([396]).
ویواصل دو كوبینو وصفه لمشاهد التعزیة ویقول:
«لا أدري إنْ كان هؤلاء الممثّلون يجعلون آثارهم طبقاً لمبادئ لونجون أو سائر النقاد، ولكنْ لا يمكن إنكار أنَّ هؤلاء يؤثّرون في الناس، في الوقت الذي لا يمكن لأجمل التراجيديا التي نقدّمها أن تؤثّر في هؤلاء. فالتعزية نوع من المسرح على الطريقة اليونانيّة القديمة».
«نحن الفرنسيّين فخورون بأنّنا نريد أن نقوم بدور جميل في التعزية باستشهاد ابن الإمام عليّ. فسفير ملك فرنسا كان حاضراً في مجلس يزيد عندما أعلن عن دخول الأسرى من أهل بيت شهداء كربلاء إلى مجلسه. فالسفير يحاول أن يستعطف رحمة الخليفة الظالم على النساء والأطفال، ولكنّه لم يفلح، وقد أُصيب بالعذاب والسخط بحيث أشهر إسلامه في المجلس نفسه وأعلن أنّه شيعي، واستُشهد في المجلس. وتلاحظون كيف يكون موقف الإنسان في مثل هذه الأوضاع»([397]).
يتحدّث جورج كورزون الذي زار إيران في العصر القاجاريّ (1210 ـ 1344هـ/1786 ـ 1925م) في كتابه (إيران وقضيّة إيران) عن (تكية دولت) «في طهران حيث كانت تقام خلال العصر القاجاريّ أشهر مسرحيّة للتعزية. يصف كورزون صالة العرض في هذه التكية على النحو التالي: تقع تكية دولت في نهاية حديقة غولستان. التكية بناءٌ دائري الشكل، أعمدته تُشاهد من بعيد، وقد رأيتُها عند دخولي طهران، وكانت أعلى من البيوت المجاورة. لقد بُنيتْ هذه التكية أو المسرح لإقامة مراسم التعزية التي تؤدّى سنويّاً، ودخلت هذا المكان، وألقيت نظرة على أرجائه. كان المبنى خالياً تماماً، باستثناء عدد من الحيوانات الأليفة التي كانت محبوسة فيه، وهذا ما أثار دهشتي. فالبناء كان يضمُّ ساحة كبيرة تعلوها قبّة، في وسط الساحة حجر كبير متصل بجسر وطريق تعبره الحيوانات التي كانت تُستخدَم خلال المسرحيّة. وحول الحجر الكبير فسحة تليها خمسة كراسٍ موضوعة؛ ليجلس عليها نساء يلبسنَ العباءة السوداء خلال العرض أو إقامة التعزية، وهناك ممرّ يعبر منه الممثّلون وقرّاء التعزية([398]).في أحد جوانب التكية منبرٌ حجريٌ يعتليه الرادود ليقرأ التعزية، أو ليشرح المناسبة. إلى جانب المنبر غُرفٌ مبنيةٌ بالآجر لها سقف خفيف ومفروشة بالآجر. وهذه الغرف مخصَّصة للسيّدات داخل الحرم، وتغطيها ستائر خضراء».
«كان القيّمون على المبنى ينوون إقامة قبّة. وقيل أنّ الشاه أُعجب بـ(ألبرت هال لندن)، وكان ينوي تشييد مبنى مثله في طهران، ولكنْ تبيّن في ما بعد أنّ أساس البناء لا يتحمّل ثقل القبّة. ولهذا السبب أقاموا أعمدة لنصب الخيام خلال إقامة مراسم التعزية لتفادي أشعّة الشمس، وهذا يُشبه ما تمّ صنعه في مسارح الرومان»([399]). «عندما تطول المراسم حتى المساء، تُوقَد شموع موضوعة في شمعدانات بلوريّة منصوبة على الجدران؛ لإضاءة المكان الذي كان يُضاء بمصابيح كهربائية، ولكنَّ ذلك توقّف، ربما بسبب عدم امكانية استمرار استخدام الكهرباء»([400]).
هناك وصفان للتعزية قدّمهما كلٌّ من: إ. فلودين في العام 1841م، وجارلز تكسيير في العام 1852م، وتكمن أهميّة الشرحين في أنّهما يتناولان التعزية في المدن والقرى الصغيرة في إيران.
كما أنّ هنالك وصفاً للتعزية قدّمه إيليا نيكولافيتش برزين في العام 1852م. شرح برزين ما كان يجري في تكيّة خاجي من عروض للتعزية من الثالث من محرّم 1843م وحتى العاشر منه([401]).
وهناك كتّاب أُوروبيّون منهم الليدي شيل التي تحدَّثت عن مسرح التعزية في إيران في مذكّراتها التي نُشرت في لندن في العام 1856م([402]).
أقام السير لويس بلي في جنوب إيران في 1862م مدّة أحد عشر عاماً وقد تأثّر كثيراً بعروض التعزية في شهر محرّم، وكتب مجلّدين بعنوان (تعزية الحسن والحسين) وطُبع في لندن في العام 1879م.
روت السائحة الفرنسيّة مدام ديولافوا([403]) مشاهداتها عن التعزية في إيران بعد زيارتها لها بقولها: «اليوم هو 12 مايو يوم الجمعة، وهو عطلة عامّة ونحن خرجنا للتنزّه خارج مدينة قزوين. سمعنا فجأة صوت طبلٍ يُقرَع، فانتبهنا إليه. رأينا وسط ساحة بعيدة عن الطريق الرئيسيّة رجالاً ونساء يتجمّعون لمشاهدة عروض التعزية. فالتعزية مجلس عزاء يقام بمناسبة استشهاد الإمام علي (تقصد الإمام الحسين) وأبنائه على يد الخلفاء الأمويّين وهو خاصّ بالشيعة»([404]).
«ففي أيام محرّم الحزينة يسمع الناس قصّة الشهداء، ويظهرون سخطهم على قاتلي أولاد الرسول ويلعنونهم. لا يوجد في قزوين كما في طهران مكان خاصّ لإقامة التعزية، فالمشاهدون يجلسون على الأرض بشكل دائريّ، وتجلس النساء المحجّبات في جانب والرجال في جانب آخر. وفي الوسط يوجد مكان للعرض. على الأرض سجّادة عليها سيف ودرع. وتوجد ستارة حمراء اللون تغطّي سقف المسرح، وبدلاً من المصابيح الخافتة التي تضيء مسارحنا تضيء أشعة الشمس المسرح. يقف طفل معتمراً عمامة خضراء يردّد أشعاراً حزينة، مثلما نرى الأناشيد المقدّسة التي تصدح في المسارح اليونانيّة القديمة، ويجهش المشاهدون بالبكاء وأحياناً نرى الممثّلين يجهشون بالبكاء أيضاً حتى الذين يقومون بدور القتَلة. فالنساء يبكين أكثر من الرجال وبصوت عال. ولكن عندما تستمرّ المراسم وقتاً أطول، يبدأ المشاهدون بالحديث مع بعضهم البعض، ويدور بينهم كلام هزليّ ومضحك. يجلس رجل سمين على كرسيّ ويشير بيده إلى الممثّلين للقيام بأدوارهم (وهو ما يُطلَق عليه اسم معين البكاء). وعندما تُعرَض مشاهد عن الحرب تُسمَع أصوات الطبول»([405]).
قام السفير الإيطاليّ في طهران أنريكو جرولي بين 1950 ـ 1955 بجمع 1055 مجلس تعزية من مختلف مناطق إيران، وأهداها لمكتبة الفاتيكان في روما. وهذه المجموعة تُعدُّ أهمّ مجموعة من مجالس التعزية التي جُمعت وحظيت باهتمام الدارسين([406]).
كتب أنريكو جرولي عن التعزية ما يلي: «البحوث التي جرت خلال السنوات الأخيرة، لفتت انتباه المستشرقين نحو المسرح الإيرانيّ. فالتعزية تُقام في الليالي التي يكون فيه القمر بدراً وداخل ساحة المسجد، أو إلى جوار مرقد أحد أبناء الأئمّة. كانت التعزية في ما مضى تقام في بلاط الملوك الذين كانوا يوافقون على عرضها. ويمكن عرض وثيقة من هذه التعزية على شكل رسم على القماش، يحفظ الآن في قصر غولستان. فالممثّلون يغطّون وجوههم، ويلبسون ملابس خاصّة بالعرض. ويُستخدم في العرض مقاتلون فرسان، ويُقرأ العزاء على شكل أشعار موزونة، يلقيها المدّاحون على مشاهديهم. فالتعزية عرض حزين ينطلق من العقائد الشيعيّة، مثير للعواطف والأحاسيس، فكثير من المسرحيّات ترتبط بمصيبة كربلاء، ومراحل القتال بين الحسين وأنصاره والجيش الأمويّ واستشهاد الإمام الحسين بإرادته واختياره، وغفران الذنوب يوم القيامة، وشفاعة سيّد الشهداء ومراسم الدفن، والمصير الحزين لآل بيته وعشرات الموضوعات الدراميّة. فكربلاء ملهمة الفنّ الدراميّ. فمصير الإمام الحسين يثير عواطف الإيرانيّين ومشاعرهم ويحرّضهم على الثورة»([407]).
كتب المستشرق البريطانيّ إدوارد براون كتاباً بعنوان (سَنة بين الإيرانيّين)، طُبع في لندن في العام 1959م أشار فيه إلى التعزية. ترجم الكتاب بالفارسيّة ذبيحُ الله منصوري، وهناك دراسة مهمّة كتبها بي دي أرتمانس([408]).
قام الباحثون الروس بدراسات حول مسرح التعزية، ومنهم (ئي. برتلس)، وطُبعت دراسته في مجلة (مسرح الشرق) حيث كتب رسالة عن المسرح الإيرانيّ بعنوان (المسرح في إيران)([409]).
وكتب الأوكراني (آغاتانغل كريمسكي) مقالاً عن المسرح الإيرانيّ، ضمّنه شرحاً عن مسرح التعزية، وطُبع الكتاب في العام 1926 في كييف. تُرجم المقال بالإنجليزيّة ويُعدّ مهمّاً من وجهة نظر المختصّصين في المسرح([410]).
جمع ويلهالم ليتن خمسة عشر مجلساً للتعزية، ونشرها بعنوان: (العرض المسرحيّ في إيران) وطُبع في لايبزيغ في برلين في العام 1929([411]).
بعد الحرب العالميّة الثانية اهتمَّ الأوروبيّون بمسرح التعزية، ومن بينهم أبه ار.اج دو جونره الذي قام بترجمة المجلس الثامن عشر من مجموعة خوجكو. في العام 1950م كتب شارل ويروللو كتاباً عن مسرح التعزية، وفي العام نفسه قام المستشرق الفرنسيّ المعروف هنري ماسه بترجمة (مجلس عرس القاسم)([412]).
قام الروسيّ أتوره بوضع فهرس توصيفي للتعزية، وبعد وفاته قام مسيو بومباجي بإكماله ونُشر في العام 1961.
وكان للمستشرقَينِ الإيطاليّين دورٌ في دراسة مسرح التعزية، وقد ترجم المستشرق الإيطاليّ بوزاني عدّة مجالس للتعزية من مجموعة جرولي بالإيطاليّة.
«زار إيرانَ سيّاحٌ وتجّار ومبعوثون غربيّون خلال العصر الصفويّ (907 ـ 1135هـ/1501 ـ 1722م)، وكتبوا تقارير عن مشاهداتهم، ولا سيّما ما شاهدوه من مراسم ومشهديّة التعزية، وطُبعت هذه التقارير في الغرب، وأصبحت أهمّ المصادر لدراسة التعزية عند الأوروبيّين»([413]).
هل دخلت الأساطير مسرح التعزية؟
عندما نقرأ نصوص مجالس التعزية الموجودة بين أيدينا بتمعّن، نرى أنّ بعض هذه المجالس تتضمّن أحداثاً وأخباراً غير طبيعيّة، وخوارق تثير التساؤل عند القارئ وتجعله يستفسر عن حقيقتها، وكيف أنّها دخلت نصوص مجالس التعزية؟
نحن نعلم أنّ نصوص التعزية كُتب معظمها في العصر القاجاريّ، وكان كتابها مجهولين، ولكنّ السؤال المطروح هو من أين أتى كتّاب مجالس التعزية بهذه الحوادث غير الطبيعيّة؟ ومن أيِّ المصادر نقلوها؟ وما هدف نقل وكتابة مثل هذه الأحداث في مجلس تعزية الإمام الحسين؟ فالحوادث غير الطبيعيّة لم تدخل فقط في نصوص مجالس التعزية، بل إنّ بعض كتب المقاتل التي تضمّنت نقل أخبار واقعة عاشوراء تضمّنت مثل هذه الأخبار، وقد انتبه العديد من علماء الدين الشيعة لهذا الأمر وكتبوا عنه بإسهاب.
فقد كتب الشيخ مرتضى مطهّري([414]) كتاباً بعنوان (تحريفات در واقعه تاريخى كربلا) [تحريفات في واقعة كربلاء التاريخيّة]، فنّد فيه ما يُنقل في كتب التاريخ من حوادث غير عاديّة وقعت يوم عاشوراء، ونقلها كتّاب تحدّثوا عن حوادث رافقت يوم مقتل الحسين في العاشر من محرّم سنة 61 للهجرة.
ويرى الشيخ مطهّري أنّ هناك أسباباً عديدة لتحريف واقعة عاشوراء، ودخول الأساطير والخرافات إلى الكتب التي تتحدّث عن واقعة عاشوراء، منها محاولات الأعداء تشويه أهداف ثورة الحسين، ولا سيّما ما بذله بنو أميّة من جهود لتصوير الحسين بن علي بأنّه خرج على ولي الأمر (يزيد بن معاوية)، وبأنّه كان يهدف إلى الوصول إلى الحكم، بينما الحسين أعلن عن أهداف ثورته بالقول: «أَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَلَا بَطِراً وَلَا مُفْسِداً وَلَا ظَالِماً، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي|، أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ المنْكَرِ، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ×، فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ بِالْحَقِّ، وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ»([415]). كما أنّ الإنسان بطبيعته يحبُّ إضفاء الصفات البطوليّة على الأبطال والشخصيّات الذين يحبّهم، ونسج الأساطير والخرافات والبطولات حول البطل الذي يهواه. وهناك سبب آخر يُضاف إلى السببين المُشار إليهما وهو تأكيد أئمّة أهل البيت على ضرورة إحياء ثورة الحسين وواقعة كربلاء.
ويرى الشيخ مطهّري: «أنّ هناك من يستخدم قضيّة غير مقدّسة من أجل إثبات قضيّة مقدّسة؛ أي أنّ هناك أشخاصاً يعتقدون بمقولة ميكيافيلي بأنّ (الغاية تبرّر الوسيلة)، وهم يعملون بشتّى السبل، ويستخدمون شتّى الطرق من أجل إحياء قضيّة مقدّسة وهي ثورة الحسين، أي أنّ الإنسان يحاول استخدام أيِّ وسيلة للوصول إلى هدفه» ([416]).
من أهمّ مآخذ مرتضى مطهّري على كتاب (روضة الشهداء) للملا حسين واعظ كاشفي ذكره رواية غير موثَّقة حول عرس القاسم بن الحسن، ذكر فيها بأنّ الحسين ابن علي قال يوم عاشوراء وهو يواجه جيش يزيد بن معاوية «أعدّوا العدَّة لأنّي أُريد أن أرى عرس القاسم مع إحدى بناتي». ويعلّق آية الله مطهّري على هذه المقولة بالقول: «كان القاسم بن الحسن ابن الثالثة عشرة فكيف يمكن للحسين وهو يواجه جيشاً جراراً يوم عاشوراء، ولا مجال لإقامة فريضة الصلاة، أن يقول مثل هذا الكلام؟ فما نراه منذ القدم والذي يجري على لسان بعض الخطباء هو مثل هذا الموضوع أي عرس القاسم، لم يُذكر في أيٍّ من كتب التاريخ الصحيحة. وينقل آية الله مرتضى مطهّري عن كاتب آخر وهو حاجي نوري القول بأنّ أوّل من طرح قضيّة عرس القاسم هو الملا حسين واعظ كاشفي في كتابه (روضة الشهداء) وأنّ القضيّة غير صحيحة وكاذبة مائة بالمائة([417]).
ويرى الشيخ عبّاس القميّ([418]) صاحب كتاب (منتهى الآمال) و(مفاتيح الجنان) بأنّ عرس القاسم في كربلاء وزواجه بفاطمة بنت الحسين لا أساس له من الصحّة؛ إذ لم يرد ذلك في الكتب المعتبرة، وأنَّ الحسين كان له بنتان إحداهما سكينة وكانت متزوجة بعبد الله الذي استُشهد في كربلاء، والأخرى فاطمة وكانت متزوجة من الحسن المثنى وقد شهد واقعة كربلاء([419]). وكان للحسين بنت أخرى وهي فاطمة الصغرى التي بقيت في المدينة، ولا يمكن القول بأنّها تزوجت القاسم([420]). يقول الحاج ميرزا حسين نوري([421]) في كتابه (لؤلؤ ومرجان): «لم نجد في الكتب الموثوقة أيْ كتب الحديث والنسب والسير، أنّ الحسين كان له بنت غير متزوجة، حتى يمكن القول بأنّه زوّجَ ابنته للقاسم بن الحسن»([422]).
فالمتتبّع للكتب التي تناولت عرس القاسم يرى أنّ هذه الرواية التي تقول بأنّ الحسين قال يوم عاشوراء «أعدّوا العدة لأنّي أريد أن أرى عرس القاسم مع إحدى بناتي» لا يمكن قبولها؛ لأنّ الكتب التاريخيّة لم تذكر هذا الموضوع إلّا عدد محدود منها. فكان من الممكن أن يُقدم الحسين على تزويج ابنته للقاسم بن الحسن وهو في المدينة قبل توجّهه إلى كربلاء، وليس في يوم عاشوراء الذي قُتل فيه القاسم وأهل بيت الحسين. فقصّة عرس القاسم ـ كما أشرنا سابقاً ـ وردت لأوّل مرّة في كتاب (روضة الشهداء) لمؤلّفه ملا حسين واعظ كاشفي، وسار الكتّاب الإيرانيّون على خطاه. فكثير من الشعراء نظموا أشعاراً حول عرس القاسم، ولا زال النائحون والرواديد يردّدون هذه الأبيات في مجالس العزاء في إيران.
ففي البيتين التاليَين نرى الشاعر يستعمل صفة العريس للقاسم بن الحسن حين يقول:
|
شد چوآغشته بخون پیكر داماد حسین |
الترجمة:
عندما ضُرِّج صِهرُ الحسين بدمه/ أطلق الحسين صيحة من على قمة الأفلاك
وتأسَّف كوكب الزهرة على حال العروس/ التي رأت رأس عريسها على الرماح يُدار
أو ما قاله شاعر آخر بهذا الشأن:
|
خطاب كرد به زینب كه ای ستمكش دهر بیا وبهر یتیم حسن بیار كفن عروس دید كفن چون به گردن داماد |
الترجمة:
خاطب الحسين أخته زينب قائلاً تعالي يا مظلومة الدهر وأجلبي كفناً ليتيم الحسن
عندما رأت العروس عريسها وعليه الكفن، عندها شقّت ثوبها حزناً عليه.
عند مراجعة كتاب (روضة الشهداء) بالفارسيّة، نرى أنّ مؤلّف الكتاب ملا حسين واعظ كاشفي، هو الذي طرح لأوّل مرّة موضوع عرس القاسم، وسار الشعراء والخطباء والكتاب من بعده على نهجه([425]).
كان ملا حسين واعظ كاشفي خطيباً وواعظاً، وكان كتابه (روضة الشهداء) أوّل كتاب عن المراثي الحسينيّة باللغة الفارسيّة، وقد كُتب قبل خمسمائة عام، لأنّ وفاته كانت في العام 910 للهجرة أي أوائل القرن العاشر للهجرة، ويشير آية الله مطهّري إلى كتب المقاتل ومنها كتاب (الإرشاد) للشيخ المفيد الذي كُتب عن مقتل الحسين، والذي يخلو من هذه القصّة، ويعجب الكاتب من كتاب (روضة الشهداء) ومن كاتبه ويقول «عندما قرأت الكتاب رأيت أنّ الأسماء الواردة في الكتاب أي أسماء أصحاب الحسين ملفّقة أيضاً، ولا وجود لهذه الأسماء، ويضيف بأنّ كاتب روضة الشهداء قد كتب قصصاً على شكل أساطير. كان أغلب قرّاء المصائب أُميّين لم يراجعوا الكتب العربيّة، ليتعرّفوا على مقتل الحسين. إنّهم كانوا يقرأون كتاب روضة الشهداء، ويقرأون مصائب سيّد الشهداء، ولهذا السبب سُمّيت مجالس مصائب الحسين بـ(روضه خوانى) أي قراءة المصائب والنياحة على الحسين»([426]).
ويرى آية الله مطهّري أنّ قراءة مصائب الحسين لم تكن في عهد الإمام الحسين ولا في عهد الإمام الصادق، ولا في عهدالإمام الحسن العسكري، ولا في عهد السيد المرتضى، ولا في زمن نصير الدين الطوسيّ، بل إنّ قراءة المصائب بدأت منذ خمسمائة عام أي منذ تأليف كتاب روضة الشهداء. ويضيف: «منذ أن وقع هذا الكتاب بأيدي الناس لم يطالع أحد التاريخ الواقعيّ للإمام الحسين، بل قرأوا الأساطير في كتاب روضة الشهداء؛ أي أصبحنا قرّاء المصائب، أي نقلنا الأساطير، ولم نهتمّ بتاريخ الإمام الحسين»([427]).
ومن بين الأساطير التي تروى عن يوم عاشوراء مجيء زعفر جنّي زعيم الجنّ على رأس جيش من الجنّ إلى كربلاء في يوم عاشوراء وعرضه على الحسين أن يقاتل الجنّ معه ويحاربوا جيش بني أُميّة، ولكن الحسين رفض مساعدة الجنّ([428]) ولم تشر المصادر الشيعيّة إلى أي خبر أو رواية عن زعفرٍ جنّي.
ومن الأساطير أنّ أحد سلاطين الهند، ويسمّى سلطان قيس، طلب المساعدة من الحسين، عندما كان خارجاً للصيد وهاجمه أسد في الصحراء، وقد جاءه الحسين من كربلاء، وهو عطشان ومجروح إثر القتال؛ ليساعده في مواجهة الأسد، وهنا يقع الأسد على رِجل الحسين ويبكي ويذهب بعيداً. وعندما يرى سلطان قيس حالة الإمام الحسين يقترح عليه مدّ يد المساعدة إليه، ولكن الحسين يقول له: «أنا قتيل العبرات» وأعطاه حفنة من التراب، وقال له إذا تغيّر لون التراب إلى اللون الأحمر فاعلم بأنّني قد استُشهدت، فابكِ عليّ. ولم ترد هذه الرواية في الكتب التاريخيّة، وأوّل من نقل هذه الرواية هو السيد محمّد باقر بن حسيني غنجوي في كتابه (مرقاة الإیقان في التقرّب إلى السبحان) تاريخ تأليفه سنة 1352هـ، ولم يذكر المؤلّف مصدر الرواية التي نقل عنها.كما نقل الرواية بصورة مختصرة محمّد إبراهيم جوهري الهرويّ في كتابه (طوفان البكاء في مقاتل الشهداء) تاريخ تأليفه سنة 1250هـ، ولكنّه لم يشر إلى مصدر الرواية. كما نقل الرواية محمّد تقي بن محمّد البرغاني القزوينيّ المسمّى بالشهيد الثالث في كتابه (مجالس المتّقين) تاريخ تأليفه سنة 1285هـ. ومن الكتب التي وردت فيها روايات ضعيفة وغير موثَّقة عن يوم عاشوراء واستشهاد الحسين كتاب (إكسير العبادات وأسرار الشهادات) للملا آغا فاضل دربندي، وهذا الكتاب يُعدّ من كتب المقاتل([429]).
أنموذج آخر على تحريف وقائع عاشوراء هو الحوار بین الحسین وملَكین نزلا من السماء؛ لتقديم العون له في معركة كربلاء، ويرفض الإمام مساعدة الملَكَين. ذكرت بعض مجالس التعزية قصّة الدرويش الذي جاء لنصرة الحسين يوم عاشوراء وكذلك قصّة الرجل الذي جاء برسالة إلى الحسين يوم عاشوراء من ابنته التي بقيت في المدينة، وما كان ردّ الحسين على هذه الرسالة.
وذكر الملا آغا فاضل دربندي صاحب كتاب (إكسير العبادات وأسرار الشهادات) مبالغات في عدد القتلى من جيش بني أمية يوم عاشوراء على يد الحسين ابن علي وأخيه العبّاس بن علي.
ويشير آية الله مرتضى مطهّري إلى أسماء لأصحاب الحسين وردت في كتاب (روضة الشهداء) لكاتبه الملا حسين واعظ كاشفي لم تكن صحيحة، وأن مؤلّف روضة الشهداء اختلقها من عنده.
ومن أجل تنبيه الناس إلى دخول هذه الأساطير والخرافات إلى كتب المقاتل قام عدد من علماء الدين بتأليف كتب للردّ على هذه الأساطير والخرافات، ومن أبرز هؤلاء العلماء العالم اللبنانيّ السيد محسن الأمين العامليّ الذي كتب العديد من الكتب عن ثورة الحسين، وردّ على مَن اختلقوا الأخبار والأساطير والخرافات وأدخلوها إلى كتب المقاتل أو طقوس عاشوراء.
وتولّى السيد محسن الأمين العامليّ تأليف العديد من الكتب حول عاشوراء واستشهاد الحسين ومن أبرزها:
«لواعج الأحزان؛ الدرّ النضيد في مراثي السبط الشهيد؛ أصدق الأخبار في قصّة الأخذ بالثار؛ المجالس السنيّة؛ إقناع اللائم على إقامة المآتم، والتنزيه لأعمال الشَّبيه»، ردّ فيها على من كانوا يحرّفون طقوس عاشوراء([430]).
تحدّث السيّد محسن الأمين عن كتابه (المجالس السنيّة) والهدف من تأليفه بالقول: «والمجالس السنية إنّما ألّفناها لتهذيب قراءة التعزية، وإصلاحها من العيوب الشائنة والمحرّمات الموبقة من الكذب وغيره، وانتقاء الأحاديث الصحيحة الجامعة لكلّ فائدة»([431]).
دُوِّنت كتب عديدة أخرى للردّ على تحريف واقعة عاشوراء وإدخال الأساطير والخرافات عليها، ومن هذه الكتب: كتاب (لؤلؤ ومرجان) لمؤلِّفه حسين بن محمّد تقي نوري الطبرسيّ (1254 ـ 1320هـ) والملقّب بالمحدّث النوري. فقد حذّر المؤلّف من إدخال أخبار مختلَقة وكاذبة في تعزية الإمام الحسين، وشدّد على ضرورة تطهير الكتب من الأساطير والخرافات. كما ضمّن آية الله مرتضى مطهّري كتابه (حماسه حسيني) [الملحمة الحسينيّة] جانباً من تحريفات عاشوراء، مشدّداً على ضرورة محاربة الأساطير والخرافات التي تُحاك حول واقعة كربلاء.
إنّ البحث حول نشأة مسرح التعزية ومدى تأثّر الإيرانيّين بالخارج في أقامته، لن يقلّل من شأن وأهميّة التعزية كونها عرضاً دينيّاً؛ إذ إنّ التعزية عرض إيرانيّ بدأه الإيرانيّون، وطوّروه على مرّ الزمن حتى وصل إلينا بهذا الشكل الذي نراه اليوم.
فواقعة كربلاء هي التي شكّلت المادّة الرئيسيّة لمشهديّة التعزية، وهذا هو العامل الرئيسيّ في نشأة التعزية وتطوّرها عبر القرون. لم يختلف الكتّاب حول كيفيّة إقامة التعزية، ولكنّهم يختلفون حول ما إذا كانت التعزية من بَنات أفكار الإيرانيّين من دون أيّ تأثير خارجيّ، أم أنّ هناك عوامل خارجيّة أثّرت في التعزية وساعدت على تطوّرها عبر قرون مضت.
إنّ ما يختلف حوله الباحثون في شأن التعزية بداية نشأتها، وكيفيّة تطوّرها عبر السنين، ويتساءل البعض من الباحثين هل مشهدية التعزية بوضعها الحالي المتكامل حصلت نتيجة تطوّرها عبر سنين طويلة؟ أم أنّها كانت كاملة منذ نشأتها ولم تتأثّر بعوامل خارجية؟
يرى الكاتب والباحث الإيرانيّ محمّد جعفر محجوب أنّ الإيرانيّين قبل قيام الحكومة بإرسال مبعوثين رسميّين إلى أوروبا لدراسة مسرح التعزية والتمهيد لذلك كانوا قد زاروا أوروبا، وشاهدوا المسرح الأوروبيّ، وقاموا بتقليده بصورة ناقصّة. وهم أخذوا فكرة عرض مصائب أهل البيت من الغرب وجاءوا بها إلى إيران، وطبّقوها في بلادهم بعرض واقعة كربلاء ومصائب أهل البيت([432]). يعتقد محمّد جعفر محجوب أنّ مسرح التعزية في إيران مأخوذ من العروض المسرحيّة الأوروبيّة في القرون الوسطى، وعلى هذا يعتقد أنّ مسرح التعزية ما هو إلّا إعادة إنتاج العروض الأوروبيّة في إيران([433]).
يقول محجوب في هذا الصدد: «بعد الحروب الصليبيّة، سافر الإيرانيّون إلى الدول الأوروبيّة؛ وهؤلاء عند زيارتهم للأراضي المسيحيّة رأوا أنّ المسيحيّين يقيمون مسرحيّات دينيّة باسم (مسرح ميراكل ومسرح ميستر) لشرح قصص قدّيسيهم. ويضيف يبدو أنّ ما عُرض من مسرح وقائع كربلاء خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديّين كان تقليداً للمسرح الذي نُقل إلى إيران من أُوروبا سنوات قبل اندلاع الثورة الفرنسيّة. فالإيرانيّون في شمالي إيران الذين كانوا أقلّ تعصّباً وأقاموا هذه العروض في أماكن مجهولة، فالنتائج كانت راقية والناس كانوا يتقبّلونها بحماس والمؤمنون كانوا يذرفون الدموع كثيراً»([434]).
لكنّ مارتن ورمارزن الباحث الهولنديّ يفنّد وجهة نظر الدكتور محجوب ويقول: «إنّ مسرحيّتَي ميستر وميراكل متأثّرتان بدين ميترا. حيث انتقل هذا الدين من إيران إلى أوروبا. ويضيف مارتن ورمارزن» ميترا هو إله النور، وهو يقاتل في خدمة أهورامزدا، ومعروف بـ(أمشاسپندان)، ونظير لما يجرى في الهند، وهناك إلى جانب ميترا آلهة أكبر مثل أريامن (الإله حامي الآریّین) وبهاگا (إله المصير) الذي بيده مقدَّرات الناس، ويقوم بتقسيم الهدايا. ففي الهند يتصل هذان الإلهان ويسميّان سراؤوساو وآسى وهما يتميّزان عن ميترا. وهما يظهران في مسرحيّات القرون الوسطى المسيحيّة على شكل كوتس وكوتوباتس([435]).
لكنّ الكاتب الإيرانيّ علي شريعتي يؤيّد فكرة نقل التعزية من أوروبا إلى إيران، ويرى أنّ الصفويّين نقلوا مظاهر العزاء من أوروبا إلى إيران، وقلّدوا المسيحيّين في المراسم التي كانوا يقيمونها بعرض مصائب المسيح والحواريین وشهداء المسيح. كما يعتقد بأنّ الصفويّين نقلوا الرموز والشعائر والأدوات المستخدمة في مراسم المسيحيّين إلى إيران، وصبغوها بصبغة شيعيّة([436]). ويضيف علي شريعتي أنّ الصفويّين نقلوا جميع مظاهر الحزن من أوروبا إلى إيران، ولا سيّما مواكب العزاء المتحرّكة، والتشابيه والنعوش، وحمل الصناديق والرسوم على الأقمشة والستائر، ورسم صور الأئمّة والأولياء، وتسيير مواكب الزناجيل والتطبير والقتال، وتعليق الأقفال واستخدام الموسيقى والطبل، وقراءة التعزية والمصائب والنياحة الجماعيّة، وكلّ ذلك اقتباس من المسيحيّة، وكلّ من يرى ذلك يعرف بأنّه تقليد من الغرب([437]).
فالدكتور علي شريعتي ـ الذي يرى أنّ الإيرانيّين نقلوا مظاهر الحزن من أوروبا إلى إيران ـ لم يشر إلى الفارق بين حبّ الإيرانيّين لأهل بيت رسول الله، ولا سيّما الحسين ومحبّة الأوروبيّين للمسيح عيسى بن مريم، والفارق بين إيمان الإيرانيّين بالله ورسوله وأهل بيته وإيمان المسيحيّين بنبيهم عيسى واعتباره ابن الله، فارق كبير لا يمكن المقارنة بينهما. فالإيرانيّون يظهرون محبّة الحسين وأهل بيته لا من أجل التظاهر، بل لإنّهم يحبّون الحسين حبّاً جمّاً، وهم يرون أنّه استُشهد مظلوماً، ولا تزال مظلوميّته باقيةً رغم مرور أربعة عشر قرناً على واقعة كربلاء. فحبّ الإيرانيّين للحسين يظهر علانيّة في شهر محرّم، ويقوم البعضهم بأعمال تُلحقُ الأذى بأنفسهم متأثّرين بما قام به الحسين من تضحية في سبيل الإسلام، وهذا لا ينحصر بالشيعة الإيرانيّين، بل يشمل الشيعة في العراق ولبنان والسعوديّة والبحرين وباكستان والهند. بينما لم نجد في الوقت الحاضر من يقوم من المسيحيّين بايذاء نفسه حبّاً بالمسيح وما تحمّله من مصائب وأذى. وهناك من الكتّاب من يشير إلى تأثّر الإيرانيّين بالهنود والصينيّين في كتابة التعزية، خاصّة خلال زيارة التجّار الإيرانيّين للهند، وزيارة التجار الهنود لإيران وما نتج عن ذلك من تأثّر وتأثير بين الجانبين([438]).
إنّ التأثير والتأثّر بين الإيرانيّين وأي أمّة أخرى لا يمكن إنكاره، سواء في التقاليد أو في الأعراف، ولكنّ القول بأنَّ الإيرانيّين نقلوا مظاهر الحزن من أوروبا وقاموا بتقليدها في إيران هو مبالغة فجّة لا يمكن أن يقبلها العقل؛ لأنّ الحزن والتأثّر بما يراه الإنسان من فظائع هو أمر طبيعيّ لا يحتاج إلى تقليد للآخرين فيه ولكنّ التأثّر بالتقاليد والأعراف هو ممكن وجائز وغير مستبعد.
ويشكّك كاتب إيرانيّ بما يقال عن تأثّر الإيرانيّين بالغرب في إقامة مسرح التعزية حيث يُنقل ما يقال عنّ أنّ الإيرانيّين قلّدوا الإوروبيّين في إقامة مسرح التعزية بعدما رأوا المسيحيّين يؤدّون مراسم صلب المسيح.
وينقل الدكتور رضا نيازمند مؤلّف كتاب (شيعه در تاريخ إيران)]الشيعة في تاريخ إيران[ خبراً، ويقول عنه بأنّه مشكوك في صحته:«بعث سفير الشاه عبّاس الصفويّ فى فينيسيا بإيطاليا تقريراً إليه بأنّ المسيحيّين في المدينة يقيمون مسيرة جماعيّة في ذكرى صلب السيد المسيح×، وينوحون عليه ويحملون الصليب على ظهورهم». ويضيف الخبر بأنّ «الشاه عبّاس أصدر أمراً بأن يقوم أهالي إصفهان بمسيرة يومي التاسوعاء والعاشوراء، وأن ينوحوا ويلطموا وأن يحملوا معهم (علامة) تشبه الصليب»([439]).
بين مسرح التعزية والمسرح الأوروبيّ
يقول المسرحيّ الإيرانيّ برويز ممنون «إنَّ مسرح التعزية الإيرانيّ لم يكن مسرحاً واقعيّاً، ولم يعمل من أجل الوصول إلى الواقعيّة. إذ أنّ واقعة كربلاء كانت مهمّة واستثنائيّة بالنسبة لقارئ التعزية، فالدور الذي يلعبه الممثّل في التعزية هو عكس مسرح برتولد بريشت؛ لأنّه لا يلعب دور إنسان عادي مثل نفسه، بل إنّه يقوم بدور الأنبياء والأئمّة وشخصيّات تُعدّ أعلى درجة ومنزلة من الإنسان العادي، ويتمتّعون بفضائل تفوق فضائل الإنسان. فالمشاهد وحتى الممثّل نفسه يعلم أنّ هناك بونا شاسعاً بينه وهؤلاء الشخصيّات. فأيّ ممثل حتى أمهر الممثّلين في المسرح الواقعيّ لا يمكنه أن يزيل الفاصل والبون الشاسع، وهو جزء لا ينفصل عن تصوّر المشاهدين. فالحسين ليس إنساناً عاديّاً في مسرح التعزية، فالإنسان العادي أي الممثّل غير قادر على تمثيل الحسين بصورة واقعية»([440]).
إذاً، يمكن القول بأنّ مسرح التعزية له معاييره الخاصّة به التي لا يمكن مقارنتها بمعايير المسرح الأوروبيّ، ولا بدّ أن يُقاس هذا المسرح طبقا لمعاييره. فالممثّل في مسرح التعزية هو شيعيّ ولا يسمح لنفسه أن يقف إلى جانب شخصيّة مثل الإمام الحسين، وهذا من وجهة نظره كفر. فالأشخاص الذين يقومون بدور الأشقياء أي يزيد بن معاوية وقادة جيشه يدركون أنّ هناك بوناً شاسعاً بينهم وبين الفرد الشقيّ لأنّهم يكرهون الأشقياء قاتلي الحسين وأصحابه وأهل بيته. فالممثّل الشيعيّ يكره يزيد بن معاوية وشمر بن ذي الجوشن؛ لأنّ هذين الشخصيتين قد قاما بأعمال غير إنسانيّة بحقّ الحسين بن علي. ولهذا السبب فالممثّل لا يمكنه أن يلعب دور هذين الشريرين كما يُوصفان، ولا يمكن للممثّل أن يقوم بدورَيهما بصورة واقعيّة. فما يتمنّاه الممثّل الشيعيّ أن يقوم بدور الإمام الحسين، وهو قادر على لعب هذا الدور بكلّ قوة. ولكنّ الممثّل الذي يقوم بدور الأئمّة يشير خلال المسرحيّة إلى أنّه ليس الإمام الحسين، بل إنّه يقوم بدوره.
في عرضٍ لمسرح التعزية في مدينة نطنز (وسط إيران) قام ممثّل اسمه سليمان وكان يمثّل دور العبّاس بن عليّ أخي الحسين، بإلقاء بيت من الشعر نظمه هو ليعرّف نفسه للمشاهدين، ويقول لهم بأنّه ليس العبّاس بن علي، بل إنّه يقوم بتمثيل دوره:
أنا لست العبّاس بن علي، ولا هذه الأرض أرض كربلاء
أنا سليمان، خادم ملك الكبرياء([441]).
فالتعزية لا تحتاج إلى قول الممثّل ليعرِّف عن نفسه ويخبر المشاهدين بأنّه يقوم بالتمثيل فقط. فهنا لا بدّ أن نشير إلى نقطة أخرى في التعزية وهي أنّ الممثّل عندما يقوم بتمثيل شخصيّة الإمام الحسين أو أحد الأولياء يأخذ بيده قصاصة ورقة ويقرأ من على القصاصة، وهنا يجب أن لا نعدّ هذا العمل غير متقن أو أنّ الممثّل لا يتقن دوره، بل هذا يشير إلى كون الممثّل يقوم بدور الشخصيّة، وليس هو الشخصية بذاتها.كما أنّ هناك نقاطاً أخرى لا بدّ من الإشارة إليها في مسرح التعزية، ولا تُعدّ دليلاً على ضعف المسرح. ففي مسرح التعزية يقوم رجل بدور السيدة زينب أخت الإمام الحسين؛ أو إنّ من يمثّل دور الشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين يبكي من على المسرح لحال الإمام، وهو الذي يريد بعد لحظات أن يجزّ رأس الحسين، وكلّ هذه النقاط التي مرّت تشير إلى قوّة المسرح لا إلى ضعفه. فعندما يرى المشاهد أنّ قاتل الحسين يبكي عليه متأثّراً بحاله، يشعر المشاهد بمظلوميّة الحسين ويبكي أكثر على الحسين. لا يمكن أن نؤاخذ الممثّلين في غلوِّهم، كما أنّ بريشت كان يوصي ممثلي المسرح الروائيّ بالقيام بالحركات نفسها التي كان يُطلَق عليها بالحركات أو الايماءات الكلية (Allgemeine Gestus).
من أولى معايير المسرح الأوروبيّ أن يكون كاتب المسرحيّة حياديّاً في خلق الشخصيّات سواء كانت شخصيّات تقوم بدور إيجابيّ أو سلبيّ. بمعنى أنّ الكاتب المسرحيّ مسؤول في اختيار أعمال وأقوال الشخصيّات في المسرح. يُعِدّ فشيلر الحياديّة من أهمّ مبادئ فنّ الكتابة.
لكن لا يمكن أن نساوي بين من يكتب نصوص مسرح التعزية، ومن يكتب نصوص المسرحيّات الأوروبيّة والعالميّة. فكاتب نصوص التعزية هو شيعيّ، ولا يمكننا أن نعدّه حياديّاً، بل هو من أنصار الأولياء؛ أي الحسين وأهل بيته. فكتّاب مجالس التعزية عندما يريدون كتابة نصّ مسرح التعزية عن الإمام الحسين يكتبون العنوان التالي: (نسخة الإمام&).
لكن الكاتب نفسه عندما يريد أن يكتب نصّ مسرحيّة عن الشمر بن ذي الجوشن يكتب (نسخة الشمر الملعون). وهذا ما يشير إلى أنّ الكاتب ليس حياديّاً، بل إنّه يناصر الحسين ويعادي الشمر. ولهذا السبب ـ أي عدم حياديّة الكاتب ـ تكون الكتابة عن الشخصيّات غير مكتملة طبقاً للقوانين المنطقيّة والعقليّة وأصول علم النفس.
فواقعة كربلاء لم تكن واقعة عادية، ورواية التعزية ليست شرحاً لوقوف الحسين في وجه يزيد بن معاوية، بل أنّها رواية صراع بين المظلوم والظالم، والشجاع والجبان والزاهد والفاسد، والحياة الأخرويّة والعالم الماديّ، والجنّة والنار، وحكاية الخير والشرِّ.
إنّ إطلاق صفة البساطة على مسرح التعزية هو المعيار في تمييز مسرح التعزية عن المسرح الواقعيّ للغرب، فالمسرح الغربيّ هو على عكس مسرح التعزية؛ يتضمّن الرياء والغشّ والدسائس، فالممثّل الذي باطنه سيّء لكنّ ظاهره وديع يتحدّث عن الإنسانيّة في الوقت الذي هو مفعم بالرذيلة. فشمر في مسرح التعزية يعترف بأنّه ظالم ويقول:
أيّها الناس، أنا شمر بن ذي الجوشن
أذهب برأس الإمام الحسين
لا أخاف خالق الكونين
أنا سأطيح بالحسين
سأزلزل العرش الأعلى
أجعل أُخته أسيرة عند الأوغاد
آخذها حاسرة الرأس إلى الشام
لا أخاف من الخالق الأكبر
فكيف أخاف من النبي الأعظم([442])؟
زار المسرحيّ البريطانيّ المعروف بيتر بروك إيران وشاهد عن قرب مسرح التعزية، وكتب عن مشاهداته عروض التعزية في إيران يقول: يوجد في إيران مسرح استثنائي وقويّ، يسمّى (تعزية) ويُعَدّ المسرح الوحيد في العالم الإسلاميّ، «هذا المسرح يقوم على تمثيل وفاة زعيم إسلاميّ، ويمثّله القرويّون لأهالي القرى أنفسهم. وقد منع الشاه رضا بهلويّ هذا النوع من المسرح لسنوات طوال، ولكنّ هذا المسرح كان يُقام سرّا في ثلاثمائة أو أربعمائة مدينة في وقت واحد وخلال مراسم. شاهدتُ مسرحاً مهيّجاً وعاطفيّاً جداً في قرية إيرانيّة، لم أشاهده في حياتي مطلقاً من ذي قبل، حيث كان المسرح يظهر استشهاد الإمام الثالث عند الشيعة. كنا ثلاثة أجانب تمكّنا من مشاهدة هذا المسرح بين القرويّين الذين جاءوا لمشاهدته. أُجري هذا المسرح بشكل بسيط جداً، وكان مؤثّراً وعاطفيّاً جدّاً. كان المشاهد يعلم بأنّ الواقعة حدثت في القرون الماضية، ولكنّ هذه الواقعة كانت تُمثَّل من جديد. فالشهيد كان يظهر من جديد أمام ناظريهم، وكان المشاهدون يبكون بشدّة. فبكاؤهم كان شديداً لم أر بكاءاً مثله سوى بكاء الناس بعد تعرّض مدنهم إلى القصف. فتمثيل المسرحيّة كان بمضمون واقعيّ وطبيعيّ بصورة كاملة. فهذا المسرح الذي كان يدور حول التعزية أثار ردود أفعال كبيرة، وضجّة بسبب نجاح التمثيل»([443]).
ويضيف بيتر بروك: «بادر الشاه والمسؤولون الإيرانيّون إلى إقامة مهرجان شيراز الدولي (في سنة 1976م) وضمّوا برنامج (التعزية أكبر كنز وطني إيرانيّ) إلى هذا المهرجان؛ ليظهروا أمام العالم وجهة ليبراليّة. وكنت قد شاهدت كيف أنّه يمكن تعبئة جماعة في ليلة واحدة يأتون من مكان يبعد عدّة كيلومترات؛ ليحطّموا الرتابة الطبيعيّة مرّة واحدة»([444]).
أوجه الشبه والاختلاف بين عروض التعزية، والعروض المسرحيّة في القرون الوسطى
هناك وجوه تشابه واختلاف بين عروض التعزية التي تُقام في إيران والبلدان العربيّة والإسلاميّة، وبين العروض المسرحيّة التي كانت تُقام في القرون الوسطى في أوروبا.
فالموضوع الرئيسيّ للتعزية هو استشهاد الإمام الحسين، بينما العروض المسرحيّة الدينيّة في الغرب كانت تتناول القيم الدينيّة للكنيسة. كما أن عروض التعزية كانت تقام في أماكن دينيّة مقدّسة، بينما كانت العروض المسرحيّة في القرون الوسطى تُقام في الكنائس.
فالعروض المسرحيّة في القرون الوسطى كانت تُقام خلال يومين إلى أربعة أيام، فالعرض المسرحيّ الذي أقيم بعنوان: Passion de Sumur عن مصائب المسيح، استمرّ ليومين حيث قُرأ 9500 بيت من الشعر، كما أنَّ عرضاً مسرحيّاً آخر عُرض باسم Mystere de la Passion في سنة 1450 للميلاد استمرّ أربعة أيام([445]).وكان الهدف من العروض المسرحيّة في القرون الوسطى هو عرض عذاب الإنسان وضرورة التأكيد على وجود العدالة الاجتماعيّة. وهناك نقطة مشتركة بين عروض التعزية وعروض القرون الوسطى، وهي أنّ الشعر كان اللغة المشتركة لفهم العامّة.
الممثّلون في التعزية ومسرح القرون الوسطى هم ناس مؤمنون ومتديّنون، وهذه العروض كانت تُدعم من المواطنين، وليس من الحكومات. إنّ من كانوا يكتبون التعزية والمسرح في القرون الوسطى كانوا مجهولين. كما أنّ نصوص التعزية والمسرح الدينيّ في القرون الوسطى كانت نصوصاً دينيّة، ولكنّها كانت تميل إلى السياسة. كانت عروض التعزية قد توسّعت في العهد القاجاريّ، وعدّ أوجن فلاندن الذي أقام في إيران في العصر القاجاريّ عروض التعزية بأنّها العروض المسرحيّة نفسها التي كانت تُقام في أوروبا في القرون الوسطى([446]).
فالتعزية في العالم الإسلاميّ كانت ترتبط بمعتقدات الشيعة، بينما العروض المسرحيّة في القرون الوسطى في أوروبا كانت ترتبط مباشرة بالمعتقدات المسيحية([447]). وخلافاً لرأي الدكتور شريعتي فإنّ الكثير من مراسم التعزية التي تُقام حاليّاً في البلدان الإسلاميّة، وخاصّة عند الشيعة يرجع إلى القرن الأوّل للهجرة، حيث كان شيعة أهل البيت يقيمونها عند زيارة مرقد الحسين وأئمّة أهل البيت، ويقيمون النياحة ولبس السواد واللطم والبكاء وزيارة قبور الأئمّة، بحيث نرى أنّ فقهاء أهل السنة ولا سيّما ابن تيمية كانوا يحرّمون هذه الأعمال، ويصدرون الفتاوى بتحريمها، ويعدّونها من البدع المحرّمة في الإسلام([448]).
كان الممثّلون يمارسون التمثيل في عروض التعزية منذ الصغر، ويتدرّبون على التمثيل والقيام بأدوارهم، ويتمّ اختيار الممثّل لما يتمتّع به من صوت وممارسة في التمثيل. فالممثّل الذي يبدأ التمثيل بالقيام بدور العبّاس بن عليّ يواصل القيام بهذا الدور، وكذلك الذي يمثّل دور شمر بن ذي الجوشن.
الصوت الذي يمتلكه الممثّل له أهميّة كبيرة في القيام بدوره في عروض التعزية. فالذي يمثّل دور الأولياء؛ أي الحسين وأنصاره يجب أن يتحلّى بصوت جميل، والذي يقوم بتمثيل دور الأشقياء (يزيد وأتباعه) عليه أن يمتلك صوتاً خشناً وفظّاً؛ لكي يستخدمه في إطلاق الصيحات والتهديدات. والممثّلون الذين يمثّلون دور العبّاس بن عليّ أو الحرّ بن يزيد الرياحي عليهم أن يتحلّوا بوجه جميل وقدٍّ فارع وطويل، لأنَّ ّكتب التاريخ تذكر لنا بأنّ العبّاس بن علي كان جميلَ المحيّا، وفارع الطول.
فالممثّل مهما كان دوره يجب أن يتحلّى بشخصيّة قوية، سواء كان يمثّل أدوار الأولياء أو أدوار الأشقياء. في عروض التعزية على الممثّل أن يجيد الألحان والغناء، فالأشقياء مثل الحارث وابن سعد والشمر يصدرون الأوامر ويتحدّثون بصوت خشن وبفظاظة. يحاول الممثّلون التأثير في المشاهدين بقراءة أشعار الرثاء والحزن والبكاء على الحسين الشهيد والشهداء من أهل البيت، وفي أحيان يخرج الممثّلون من مكان العرض ليختلطوا بالمشاهدين. يريد الممثّلون من وراء القيام بأدوارهم أن يحصلوا على الثواب الأخرويّ، وليس هدفهم الحصول على الهدايا التي ربّما يحصلون عليها في نهاية العرض.
فالكاتب والممثّل والمشاهد جميعم يهدفون إلى الحصول على الثواب من خلال كتابة مجالس التعزية، أو التمثيل أو مشاهدة العرض المسرحيّ. الممثّل الذي يقوم بدور الأولياء في العرض يقرأ الأقوال من ورقة في يده، وهذا يدلّ على أنّ الممثّل الذي يمثّل دور الحسين وأهل بيته ليس هو الحسين، بل إنّه يمثّل دوره، وهذا ما يريد أن يُفهمه للمشاهدين. يكون الممثّلون في عروض التعزية عادة قد تدرّبوا على الأدوار منذ طفولتهم، ولم يكن للممثل مدرّب يدرّبه على التمثيل، بل كان يتعلّم هذا الدور من المشاركة في التمثيل منذ صباه. عادة ما يكون الممثّل قد تعلّم التمثيل من أبيه أو أخيه، لأنّ التمثيل في عروض التعزية يختصّ بعوائل معيّنة تقوم بهذا الدور، حيث يقوم بهذا الدور الأجداد والآباء والأحفاد. ويرث الحفيد من الوالد والوالد من الجَد([449]).
ترابط وثيق بين الممثّلين والمشاهدين
إنّ الذي يميّز مسرح التعزية من غيره من المسارح هو ارتباط الممثّل والمشاهد أحدهما بالآخر ارتباطاً وثيقاً. حيث يقوم كلّ منهما بتكملة دور الآخر. إذ إنّه لا يمكن أن يقوم الممثّل بدوره من دون حضور الآخر؛ أي المشاهد. فقبل بدء العرض يقدِّم أحد الممثّلين أكواباً من الماء إلى المشاهدين؛ ليذكّرهم بعطش الحسين، الذي قضى عطشانَ، عندها يبدأ العرض حيث ينفعل المشاهدون من المشاهد التي تُعرَض على المسرح، فيبدأون بالبكاء والنحيب والصراخ بعد مشاهدتهم الممثّلين الذين يقومون بدور قادة الجيش الأمويّ، وهم يهمّون بذبح الحسين وأولاده وأنصاره، وحيث يشاهدون على المسرح جسد الحسين وأجساد الشهداء وهم صرعى، وهنا يصيح بعض المشاهدين قائلين للقتلة: «لا تقتلوهم، بل أقتلونا بدلاً منهم». وفي جانب من العرض يقوم عدد من المشاهدين بإحضار كبش إلى المسرح؛ كي يذبح بدلاً من الحسين، وهم يصرخون قائلين لا تريقوا الدّم المقدّس([450]).
الممثّل في مسرح التعزية يقوم بدوره على أحسن ما يرام، وهو بهذا يستخدم كلّ إمكانيّاته وطاقاته للقيام بما هو مطلوب منه، فالممثّل لا يستخدم الكلمة في الحوار، بل يقرأ الشعر الذي يفهمه المشاهدون لا عن ظهر قلب، بل يقرأه من على ورقة صغيرة تُسمَّى (النسخة أو البياض)؛ لكي لا يُنسَى، ولا يطرح ما يعتمل في صدره، بل يقرأ ما هو مكتوب له. فالممثّل يعتقد أنّ دوره هو دور مقدّس، سواء كان يمثّل الأولياء أو الأشقياء. فالممثّل الذي يمثّل إحدى الشخصيّات يقوم بدورَين، الأوّل دوره كمشاهد، وهو يعيش في الحاضر، أمّا الدور الثاني دوره كممثّل وهو يعيش في الماضي، فعندما يقوم الممثّل الذي يقوم بدور الشمر بقتل الحسين فإنّه يقف مع المشاهدين، ويشهق بالبكاء على ما فعله([451]).
الديكور والملابس في عروض التعزية
لا يُستخدَم الديكور في عروض التعزية، بل إنّ المسرح يبدو خالياً من الديكور والستائر. كما أنّ الممثّلين لا يضعون الكْريمات ولا يخضعون لعمليّات التجميل. بل إنّ من يقوم بدور الأولياء ولا سيّما الإمام الحسين يجب أن يتمتّع بجمال الوجه، وأن يكون ملتحياً. كما أنّ من يمثّل العبّاس بن عليّ عليه أن يكون فارع القامة، وجميل المحيّا، ومن يمثّل دور عليّ الأكبر أن يكون شابّاً في الثامنة عشرة من عمره، والقاسم بن الحسن يمثّل دوره مراهق صغير السن، ويكون جميل الوجه. فالممثّل إضافة إلى قسمات وجهه، عليه أن يكون حسن الصوت؛ ليقوم بدوره خير قيام، أي يقرأ الأشعار بصورة جيدة([452]).
يستخدم الممثّلون في مسرح التعزية ملابس بألوان مختلفة يرمز كلّ لون منها إلى معنى خاصّ. فاللونان الأخضر والأبيض يرمزان إلى الشهيد والشهادة، واللون الأحمر يرمز إلى أنّ صاحبه من الأشقياء (أي من جند بني أميّة)([453]).
فالممثّل الذي يقوم بدور العبّاس بن عليّ يلبس اللون الأخضر، والذي يمثّل دور الأشقياء يلبس اللون الأحمر، ويضع من يقوم بدور الأشقياء وقادة جيش يزيد قلنسوة على رأسه، بينما لا يضع الممثّل الذي يمثّل دور الأولياء قلنسوة فوق رأسه، لأنّ الحسين لم يذهب إلى كربلاء من أجل خوض الحرب. فاللون الأخضر يرمز إلى محبّي رسول الله، واللون الأحمر يرمز إلى متعطّشي الدماء، واللون الأسود يرمز إلى حداد الشيعة على الحسين وأهل بيته. واللون الأبيض يرمز إلى استعداد الشيعة للشهادة والفداء. نضيف هنا أنّ في عروض التعزية يُرمَز إلى الموتى بالكفن، والأشباح بالقماش الأبيض المرخّم، والجنّ بالملابس الرثّة والأقنعة القبيحة.
ففي عروض التعزية يُقسَّم الممثّلون بحسب الوان ملابسهم. فيمكن للمشاهدين أن يعرفوا الأولياء والأشقياء من ألوان ملابسهم. فالألوان الرئيسيّة في عروض التعزية هي: الأخضر والأحمر والأبيض والأسود والأزرق والأصفر. فاللونان الأخضر والأحمر من أهمَّ الألوان في عروض التعزية. فاللون الأخضر يرمز إلى الأولياء، واللون الأحمر يرمز إلى الأشقياء. والثياب ذات الألوان الأخرى مثل الأبيض والأسود والأزرق والأصفر يرتديها المقرّبون من الأولياء.
فالثياب ذات اللون الأبيض يلبسها من يمثّل العبّاس بن عليّ، وذات اللون الأصفر يلبسها من يقوم بدور الحرّ بن يزيد الرياحيّ، واللون الأزرق يلبسه من يقوم بدور القاسم بن الحسن، وذات اللون الأسود تلبسها نساء الأولياء، وتلبس الشياطين وعزرائيل اللون الأسود.
ويعود سبب استخدام مختلف الألوان إلى ثقافة الإيرانيّين وتقاليدهم منذ أقدم العصور. فالإيرانيّون قبل الإسلام كانوا يُلبسون أبناءهم وبناتهم اللون الأخضر الذي يدلّ على البقاء والنموّ، وكانوا يلبسون بناتهم هذا اللون يوم زفافهنّ. فاللون الأحمر الذي يُستعمَل للأشقياء كان لون ملابس العسكريّين والطبقة الحاكمة قبل الإسلام. واللون الأسود تلبسه النساء، لأنّ الإسلام حرّم الزينة على المرأة ومنعها من إبداء زينتها أمام الآخرين، وأنّ السبب في لبس المرأة الإيرانيّة التشادور الأسود يعود إلى هذا الأمر.
أمّا اللون الأصفر فيعود إلى كونه لوناً بين الأخضر والأحمر، ويناسب الأشخاص الذين كانوا في البداية ضمن مجموعة الأشقياء، وتحوّلوا بعدئذ إلى جيش الإمام الحسين؛ مثل الحرّ بن يزيد الرياحيّ الذي كان أحد قادة جيش بني أميّة وقد تابَ، والتحق بجيش الحسين([454]).
اليوم إذا لم تتوافر لدى الممثّل ملابس مناسبة للعرض، فإنّه يلبس ملابس تختلف عن ملابس الناس العاديّين، ولكن من الأفضل أن تتناسب ملابس الممثّلين مع الألوان المستخدمة في العروض المسرحيّة. يلبس الممثّلون ملابس العسكريّين البريطانيّين بدلاً من لبس الدروع. فالذي يقوم بدور العبّاس بن عليّ هو الذي يحمل الرایة في جيش الحسين، ويلبس اللباس العربيّ الأبيض الطويل، كما أنّه يحمل السلاح وينتعل الجزمة، ويضع على رأسه خوذة([455]).
يرتدي الممثّل في مسرح التعزية ملابس ربّما لا تناسبه، فقد يلبس الممثّل ملابس النسوة؛ ليمثّل دور السيدة زينب أو فاطمة الزهراء وبلقيس ملكة سبأ. والممثّل الذي يقوم بدور شمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين يلبس ملابس حمراء عربيّة، ويضع نظارة سوداء على عينيه، ويأخذ بيده غطاء إطار سيارة بدلاً من الترس، كما أنّه يرفع مظلّة على رأسه؛ ليستظلَّ بها([456]) بينما يلبس الأولياء الطيّبون النظارات البيضاء التي تُستخدَم للقراءة([457]).
كما أنّ الممثّل يجلس على كرسي من الصاج؛ رمزاً لجلوسه على العرش، أو أنّه يضع إناءً فيه ماء؛ رمزاً لشطِّ الفرات، أو يضع سعفة نخل؛ رمزاً للنخيل، أو يفرش بساطاً على الأرض ويضع متّكأ؛ رمزاً لسرير النوم. ففي مسرح التعزية يمكن للممثّل أن يقوم بعدَّة أدوار، فمرّة يمثّل العبّاس بن عليّ، ومرّة يمثّل الحرّ بن يزيد الرياحي، ومرّة ثالثة يمثّل القاسم بن الحسن. وفي مسرحيّة أخرى يمثّل يوسف الصدّيق، ومرة يمثّل النبيَّ محمد|، ويمثّل مرة دور الشمر، ومرّة دور الحارث([458]).
وفي مدينة أراك الواقعة شمال غربيّ إيران، يلبس الممثّلون في مجالس التعزية ملابسَ الإيرانيّين والعرب عند تمثيلهم لأهل البيت وأعدائهم من جيش بني أمية، حيث تؤخذ الوقائع التاريخيّة والروايات والأساطير وعادات عامّة الناس وتقاليدهم في الحسبان. فالمسؤول عن الملابس هو صاحب التعزية وهو الذي يعدّ الملابس للممثّلين. وفي مدينة أراك كان هنالك خيّاط في ما مضى متخصّص في خياطة ملابس ممثّلي التعزية. وكان صاحب التعزية يشتري للممثّلين أفضل الأقمشة، ويخصّص لهم أفضل الخيّاطين، وكان يوصي الفنّانين الإصفهانيّين بصناعة الخُوَذ والقلانس، كما كان يوصي بصنع الجزمات لدى حذّائي تبريز([459]).
تُستخدم رموز عديدة في أثناء عروض التعزية في المسرح الإيرانيّ، وخروج الشَّبيه في شهر محرّم في المدن المقدّسة يزيد من تأثيرها على المشاهد. فهناك رموز تُستخدم خلال تصوير يوم عاشوراء، وهذه الرموز لها جذور إسلاميّة إيرانيّة، وتُفسَّر على أنّها أدوات لترسيخ واقعة عاشوراء في الأذهان. ويمكن الإشارة إلى عدد من هذه الرموز المستخدمة في عروض التعزية والشَّبيه، ومنها: الفَرَس، والطير، والدم، والماء، والنخل، وقِربة الماء، والكفن، والنهر، والدرج، والنقاب، والريش، والطبل، والكرسي، والجَمَل والمظلّة، والأسد، والجرس المعلّق برقبة الجمل، ونثر التبن و...إلخ.
الفَرَس الأبيض رمز للطهر والخير والحياة، والفَرَس الأسود رمز للشر والموت والشيطان. وفي الأساطير الإيرانيّة هناك أسماء لخيول خالدة منها: (شبرنگ بهزاد) وهو فرس البطل الإيرانيّ سياوش، و(رخش) وهو فَرَس البطل الفارسيّ رستم، و(شبديز) فَرَس الملك الفارسيّ خسرو برويز. وفي الثقافة العربيّة الإسلاميّة هناك خيول معروفة منها (البُراق) فرس رسول الله|، و(دلدل) فَرَس الإمام عليّ، و(ذو الجناح) فَرَس الحسين بن علي.
ذكرت الكتب التي تحدّثت عن واقعة عاشوراء ما قام به فرس الحسين المعروف باسم (ذو الجناح) بعد استشهاد الحسين في كربلاء، اذ أغار على جيش يزيد وقتل العديد من أفراده، ومرّغ رأسه بدم الحسين، وذهب إلى مخيم أهل بيته، وكان صهيله علامة على استشهاد الحسين، حيث علم أهل بيته باستشهاده، فخرج حرم الحسين من الخيام باكيات لاطمات، وتيقنّ من استشهاده([460]).
الطير رمز لنقل الأخبار، وروح الحياة، والروح والنور والعفّة والطهر والسلام والعبور من حالة إلى أخرى، ومن مرحلة إلى مرحلة أخرى. عندما نرى خلال عروض التعزية والشبيه عدداً من الطيور المُلطَّخة بالدماء تقف على ظهر فَرَس الحسين، ندرك أنّها ترمز إلى رسائل تحملها إلى محبّي الحسين وأنصاره، وتُنْبئ بوجود أجساد شهداء كربلاء ملقاة في العراء، وتنتظر من يقوم بدفنها([461]).
الدَّمُ يرمز في التعزية إلى دم الحسين بن عليّ، ودماء أصحابه التي أُريقت في كربلاء. فالدَّم في التعزية هو رمز الحياة، وقوّة الشباب؛ أي الحياة والخلود ورمز الطاقة الشمسيّة، ومظهر الحياة الجسمانيّة والروحانيّة، ودليل على إفشاء الظلم وفضح الظالم([462]).
الماء له دور أساسيّ في التعزية، فالعطش وفقدان الماء هو الأصل في التعزية. فالحسين وأصحابه ذاقوا العطش، وهم يقفون بالقرب من نهر الفرات وقد قطع جيش يزيد عنهم الماء حتى استُشهدوا عطاشى. فالماء هنا رمز للحياة والشفقة والطهارة والمكاشفة والحقِّ، وفي جانب آخر رمز للموت والفناء وعامل للهلاك([463]).
النَّخلة تُستخدَم في عروض التعزية على المسرح رمزاً لكربلاء، وصمود الحسين ابن علي واثنین وسبعین من أصحابه في وجه جيش يزيد، كما تُستخدَم النخلة رمزاً لتربة كربلاء كساحة حرب؛ لأنّ أرض كربلاء قد عُمّدت بدم الحسين، وهو رمز لانتصار الحقّ على الباطل، وانتصار الدَّم على السيف. لأنّ النخلة رمز للبقاء والصمود([464]).
القربة في التعزية ترمز إلى العبّاس بن عليّ أخ الحسين بن عليّ المُلَقَّب بساقي عطاشى كربلاء. فالعبّاس سُمِّي سقّاء كربلاء؛ إذ كان عليه أن يؤمّن الماء لجيش الحسين، وقد فعل ذلك في اليوم السابع من محرّم، ولكنَّه واجه في التاسع من محرّم جيش يزيد الذي قطع الماء عن الحسين وأصحابه وأهل بيته، وعندما حاول العبّاس الاقتراب من نهر الفرات؛ ليملأ القربة فاذا برمح يصيب يده اليمنى فيقطعها، وعندها أخذ العبّاس القربة بيده اليسرى، فاذا برمح آخر يصيب يده اليسرى وهكذا يتلقَّف العبّاس القربة بفمه، واذا برمح آخر يصيب جبهته ويقع على الأرض شهيداً([465]).
يرمز الكَفَن إلى الموت والدفن، ويعني النفس. كما يرمز الكَفَن إلى الحَمْل أي أنّ البطل الذي يلبس الكَفَن ينبئ عن وقوع أحداث سيئة منها الموت والدفن. والكَفَن رمز للحياة الأخرى، ومظهر لولادة جديدة في الحياة الأخرى. ففي إيران القديمة كان الناس يلبسون الثياب البيضاء حزناً على فقيدهم، ورمزاً لعزائهم([466]).
النَّهَر رمز للعطش، ويُوضَع خلال عروض التعزية طشت فيه ماء؛ يرمز إلى نهر الفرات الذي لم يتمكّن الحسين وأصحابه أن يرتووا من مائه وماتوا عطاشى. ويرمز النَّهَر أيضاً إلى الخلق المستمرّ للعالم، ومسيرة الحياة، ونهر الحياة، ونهر الموت والحياة، والحياة المتغيّرة، والعالَم الصغير، والعودة إلى الأصل، والنَّهَر ينبع ويعود إلى منبعه. النَّهَر يرمز أيضاً إلى صدر النبي محمّد|، والذي نزل عليه القرآن وحفظه في صدره والذي يرتوي من مائه البارد الزلال كلّ عطشان، ويطمئن الروح والنفس، ويحرّره من الجهل والظلام، ويهديه إلى وادي العشق والإلهام([467]).
الكُرسي رمز للقوّة والسلطة، فإذا استخدمه الأشقياء، فإنّه يرمز إلى البطش والفتك. أمّا إذا استخدمه الأولياء فإنّه يرمز إلى مركز المعرفة والبقاء والخلود، والعرش كما جاء في القرآن الكريم: (وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا) ([468]). كما أنّ الكرسي يرمز إلى عرش الملك أو السلطان. وفي مراسم العزاء يرمز إلى تحوّل الخلافة إلى ملك عضوض، حين تولّاها الأمويّون([469]).
الجَمَل يرمز إلى التواضع والصبر والتحمّل. فتواضع الجمل يتجلّى حين يُنزل من على ظهره راكبه أو الحمل بأن يركع على ركبتيه. وهو الذي حمل السبايا والإمام زين العابدين المريض من كربلاء إلى الشام([470]).
المَظلّة تكون كروية الشكل، يمسك بها جبريل ويظهر على المسرح. فالمظلّة رمز لعالَم اللاهوت. فقبضة المظلّة التي يمسك بها جبريل ترمز إلى ارتباطه بالعالَم العلويّ([471]).
يُنثر التِّبْن على رؤوس المعزِّين، خلال مراسم العزاء في شهر محرّم، ويرمز ذلك إلى أنَّ المعزِّين يواسون أنفسهم مع صاحب العزاء وهو الحسين بن عليّ، يقابلها لدى العرب تعفير الوجوه بالطين والرَّماد([472]).
استخدام الموسيقى في عروض التعزية
عروض التعزية تُعدُّ من العوامل المهمّة في الحفاظ على الأنغام والألحان والمقامات الموسيقيّة الإيرانيّة([473])، فلا يمكن مشاهدة عروض التعزية في إيران مجرّدة من الموسيقى؛ لأنّ الموسيقى تُعدّ أحد عوامل نجاح عروض التعزية. ويرى العديد من الموسيقيّين الإيرانيّين بأنّ عروض التعزية هي التي حافظت على الموسيقى الإيرانيّة، ولولاها لواجهت الموسيقى الفناء والإندثار. ويمكن القول بأنّ التعزية والموسيقى تكمل إحداهما الأخرى، فالموسيقى تزيدها غنى، والتعزية تحفظ الموسيقى من الزوال والفناء([474]).
يقول أبو الحسن صبا([475]) وهو من أقدم الموسيقيّين الإيرانيّين«التعزية هي التي حفظت حتى الآن الموسيقى الإيرانيّة، ويتساءل: لا أدري مع الأسف مَن سيضمن الحفاظ على الموسيقى الإيرانيّة مستقبلاً؟([476]).
وتتجلّى الموسيقى في التعزية على شكلين:
1 ـ الموسيقى الكلاميّة.
2 ـ الألحان الموسيقيّة.
فالموسيقى الكلاميّة هي عبارة عن كلام الأولياء (الأئمّة من أهل البيت) والأشقياء (يزيد وأنصاره)، وتقرأ منظومة. ويقرأ كلام الأولياء بصورة ملحّنة ويرافق ذلك الموسيقى. فكلام الأولياء يُقرأ مرّة ملحَّناً، ومرة يُقرأ بحرقة وبموسيقى.
فالممثّلون الذين كانوا يمثّلون أدوار الإمام الحسين ويزيد بن معاوية في أكبر تكيّة في إيران وهي تكية دولت (في طهران) كانوا من أحسن الممثّلين في إيران صوتاً، كانوا يتدرّبون على الموسيقى على أيدي إيرانيّين، ويتعلّمون العزف على الآلات الموسيقيّة، ويظهرون خبراتهم خلال عروض التعزية التي كانوا يقدّمونها على مسرح (تكية دولت». حافظ هؤلاء الذين تعلّموا الألحان والنغمات والمقامات الموسيقيّة على الموسيقى الإيرانيّة الأصيلة»([477]).
فالممثّل الذي كان يمثّل على مسرح التعزية كان يعزف على الآلات الموسيقيّة وكان يختار الآلة المناسبة وينقل إلى المشاهدين الأنغام المناسبة للعرض.
اختيار الموسيقى التي تناسب الشعر يُعدّ رمزاً لنجاح الممثّل في تمثيله على المسرح. فالذي يمثّل الأشقياء لا يقرأ أشعاره ملحّنة وبموسيقى، بل إنّه يقرأ الأشعار مجرّدة من الموسيقى، وبنبرة خشنة وعنيفة وعدوانيّة([478]). الشكل الثاني للموسيقى في عروض التعزية يتمثّل في الآلات الموسيقيّة وهي شيپور [المزمار] ونی [الناي] وقره نی ]مزمار القربة] وطبل [الطبلة] ودهل [الطبل الكبير] وكرنا [الكرنا] وسنج ]الصنج]. ویُستعمل كلّ منها في مناسبة من المناسبات.
ففي عروض التعزية التي تتناول مشاهد الحرب تُستعمل الطبلة، والطبلة الكبیرة والمزمار والصنج، وفي عروض الوداع أي وداع الأب لابنه يُستعمل الناي ومزمار القربة.
ويقول الخبير في موسيقى التعزية سعيد افزونتر عن الموسيقى المستعملة في عروض التعزية على المسرح: إنّ الموسيقى المستَخدَمة في عروض التعزية تكون على ثلاثة أوجه:
1: ملء الفراغ الناجم عن توقّف الحوار، أو توقّف الحركة في العرض.
2: ملاءمة النصّ لموضوع العرض.
3: صدور أوامر من معين البكاء (المخرج) لتغيير الأدوار (استعداد الممثّلين للقيام بأدوارهم)([479]).
كان كتّاب مجالس التعزية من عامّة الشعب، وكانت أشعارهم أشعاراً شعبيّة، ولم تكن لها أهميّة أدبيّة كبيرة، والنصوص تنزل إلى مستوى الحوار العاديّ بين الأشخاص، ولكن عندما تُستعمل الموسيقى في التعزية وتُقرأ الأشعار منغّمة فإنّ هذا النقص تسدّه الموسيقى، بل يصبح لها قيمة؛ ولهذا السبب يُقال إنّ نصوص التعزية تعتمد على التنفيذ وليس القراءة.
فالأنغام تكتسب أهميّة في بعض الأحيان، خاصّة مع مرور الزمن، وتغير المكان، فتغيير الزمان والمكان في التعزية يتمّ بقيام الممثّل بحركة دائريّة على المسرح، وفي هذا الفاصل تُعزف الموسيقى الملائمة للحدث. فعلى سبيل المثال إذا كان من المقرَّر أن يتوجّه شمر بن ذي الجوشن من الكوفة إلى كربلاء، عندها تُضرب الطبلة والمزمار والصنج بصورة حماسيّة. وفي بعض الأحيان يصدر الممثّل الذي يمثّل الشمر أوامره بأن يضرب مزمار الحرب، فتصبح الفرقة الموسيقيّة التي كانت ترافق الممثّلين ـ بعد صدور الأوامر ـ عضواً في الجيش الذي يُعدّ نفسه للحرب. ومن هنا فإنّ الشمر يواصل دوره حتى انتهاء العرض. ويمكن القول إنّ الموسيقى تقوم في العرض بملء الفراغ في المسرح، وإثارة الصخب الضروريّ لمواصلة العرض المسرحيّ([480]). تقوم الموسیقى بدور آخر، وهو عندما ینسی الممثّل ما یجب أن یقوله، فإنّه (الممثّل) یشیر بیده إلی عازف الموسیقی بأن یضرب على الطبلة وينفخ في المزمار، وهكذا تكون الموسيقى أداة مساعدة للممثّل لمواصلة دوره.
عندما أصدر رضا شاه بهلوي (1878 ـ 1944م) أوامر بمنع مراسم العزاء وعروض التعزية في كافّة أنحاء إيران، تمّ نسيان كثير من الأنغام والألحان الموسيقيّة المستعملة في عروض التعزية آنذاك، ولذلك نرى الكثير من ممثّلي عروض التعزية في الوقت الحاضر لا يفقهون شيئاً من الموسيقى، ولذلك فإنّهم يستعملون ألحاناً موسيقيّة في عروض التعزية ملائمة للأغاني المستعملة في الأفراح، مع أنّ هناك بعض الممثّلين من كبار السن، يحفظون الألحان التي كانت مستعملة في القرن الماضي في أثناء أداء عروض التعزية.
وعلى هذا، فإنّ الموسيقى تؤدّي دوراً رئيسيّاً في عروض التعزية، ويكون على معين البكاء وهو يقوم مقام المخرج أن ينتبه لمدى أهميّة الموسيقى في العرض، ودور الموسيقى في إنجاح أي عرض للتعزية. نشير هنا إلى أنّ الخطباء والرواديد والنائحين على الإمام الحسين كانوا يتمتّعون بصوت جهوريّ، وكانوا يعرفون الألحان الموسيقيّة([481]).
كان الإيرانيّون القدماء يستخدمون الموسيقى والألحان في مختلف المناسبات وأغلبها مناسبات دينيّة، ومنها:
(صلوات نامه) [أي طقوس الصلاة على محمّد وآل محمد]، و(چاووش خوانی) [مراسم استقبال الحجاج أو زوار الإمام الحسين العائدين من كربلاء، حيث يقرأ أحدهم دعاءً ويمشي الأقارب والأصدقاء إلى جانب الحاج أو الزائر حتى الوصول إلى بيته]، ودعاء قبل النوم للأطفال حتى يناموا نوماً هنيئاً، ودعاء أداء النذور، ودعاء الابتعاد عن البلاء والحوادث، ودعاء السَّحر (إذ يقوم المسحراتي قبل أذان الفجر بايقاظ الصائمين للصيام في شهر رمضان)، ودعاء عرس القاسم بن الحسن، ودعاء مهد علي الأصغر (ابن الإمام الحسين)، ومراسم تشييع شهداء كربلاء (في أيام محرم)، ودعاء الاستسقاء؛ أي طلب نزول المطر. كانت هذه الطقوس ترافقها موسيقى محليّة تُستخدَم في كلّ منطقة من المناطق الإيرانيّة. وكثير من هذه الطقوس تُقام بعد أن يقوم قارئ جميل الصوت بقراءة الدعاء، والأشعار المنظومة بهذه المناسبة. وكثير من هذه الطقوس اندثرت في العاصمة والمدن الكبرى مع دخول التقانة الحديثة، ولا زالت بعض هذه الطقوس موجودة في القرى والأرياف الإيرانيّة([482]).
تستخدم الأقليّات الدينيّة في إيران أنواع الموسيقى في طقوسها ومراسمها الدينيّة وصلواتها، ولكنَّ هذه الموسيقى لم تصل إلى مستوى موسيقى التعزية. فالاقليّات الدينيّة في إيران كالزرادشتيّين والمسيحيّين والأرمن واليهود والصابئة المندنائية أتباع النبي يحيى لها موسيقاها الدينيّة الخاصّة بطقوسها، وهي محدودة بالمقارنة مع الموسيقى المستعملة في عروض التعزية([483]).
إنّ إحدى القضايا التي اهتمَّ
بها الباحثون في مجالس التعزية هو المصدر
الذي استقى منه كتّاب مجالس التعزية، ومن أين أخذ كتّاب المجالس المادّة الشعريّة
المستخدَمة في التعزية. يعتقد العديد من الباحثين أنّ أوّل مصدر اقتبس منه
كتّاب التعازي في إيران، هو كتاب (روضة الشهداء) لمؤلّفه ملا حسين واعظ
كاشفي([484])وبعض
المقاتل المكتوبة باللغة الفارسيّة مثل (طوفان البكاء)([485]) و(طريق
البكاء)([486]) أو
المترجمة إلى الفارسيّة مثل: (مقتل أبي مخنف). ونقل العديد من قرّاء
المقاتل الإيرانيّين الذين كانوا في الماضي يشرحون الصور التي رُسِمت على القماش
عن واقعة كربلاء، وسُمِّيت آنذاك (رسوم المقاهي)، القصص والحكايات
المتعلّقة بشهادة الإمام الحسين يوم عاشوراء من كتاب (طريق البكاء). كما
أنّ كتاب (اللهوف على قتلى الطفوف) لمؤلِّفه ابن طاووس، علي بن موسي المولود
سنة 589هـ والمتوفّى في العام 664هـ، المترجَم بالفارسيّة والمعروف باسم (لهوف
سيد ابن طاووس)، يُعدُّ أحد مصادر مجالس التعزية في إيران.
إنّ الكتب والدواوين الشعريّة لها مؤلِّفوها وشعراؤها وناظموها عادةً، بينما نسخ التعزية هي على العكس تبقى منذ البداية مجهولة الكاتب والشاعر. ولهذا سببان:
الأوّل: هو أنّ من كان ينظم الشعر لم يذكر اسمه؛ لأنّه كان يرى أنّ عمله مقدّس، ولا يريد أن يكتب اسمه عليه، بل يطلب الأجر والثواب في الآخرة، وكان هؤلاء يعدّون كتابة أسمائهم رياءً، ولهذا كانوا يمتنعون عن ذكرها.
الثاني: هو أنّ من كان يستنسخ الشعر لم يكن يكترث لذكر اسم صاحبه وناظمه، لأنّ النسخة الأصليَّة لم يُذكر فيها اسم المؤلِّف أو الشاعر؛ ولهذا فإنَّ كثيراً من الأشخاص عندما كانوا يستنسخون الأشعار كانوا يغيّرون الشعر، ويوقّعونه بأسمائهم، ويوزّعونه على الآخرين([487]).
يمكن ذكر أسماء العديد ممّن كتبوا المقاتل أو التعازي والمراثي في العصر الصفويّ، والذين رسّخوا أسس التعازي والمراثي في إيران وهم: مولانا حسين واعظ كاشفي صاحب أوّل كتاب عن التعزية (روضة الشهداء) وهو أوّل كتب المقاتل التي كُتِبت باللغة الفارسيّة في إيران، والشاعر محتشم الكاشانيّ، والشاعر عبد الله بن محمّد علي محرّم، والشاعر كمال، والشاعر شهاب، ومحمّد طاهر بن أبي طالب، والسيد مصطفى الكاشانيّ (ميرعزا) وميرزا محمّد تقي تعزيه گردان (معين البكاء)، والشاعر مولانا محمّد بن حسام الدين المعروف بابن حسام، وكُتبُ هؤلاء وأشعارهم هي مصدر لنسخ التعازي الموجودة حاليّاً([488]).
وهناك أشخاص عُرفوا بكتابة مجالس التعزية والمقاتل مثل معين البكاء وحسين علي خان. وكان لحسين علي خان طريقة في كتابة مجالس التعزية سُمِّيت باسمه([489]).
كتّاب مجالس التعزية يختمون المجالس بطلب الدعاء لكاتبه. أو كانوا يوقّعون كتاباتهم بعبارات مثل: (سگ درگاه سید الشهداء) [كلب باب سید الشهداء] أو (كلب آستان علي) [كلب باب (الإمام) عليّ]، أو (كاتب الحروف) أو (حرره) أو (ورقك) [وريقة]([490]). كما كان البعض من الكتّاب ينهي مجلس التعزية بكلمة: پایان وتمام وإتمام [الخاتمة].
الأشعار التي كُتبت بها التعازي كانت بسيطة وباللهجة المحليّة ولغتها ركيكة، وقد كُتبت ليفهمها عامّة الناس، ولكن بعد قرنين من الزمان أُعيد النظر في هذه الأشعار، وكُتبت من جديد.
قيل إنَّ محمّد تقي خان معين البكاء أعاد كتابة نسخ التعزية، وإنَّ كتّاباً آخرین مثل شهاب الإصفهاني أعادوا ترتيب نسخ التعزية، ونشرها بتشجيع من ميرزا محمّد تقي خان أمير كبير رئيس الوزراء في عصر ناصر الدين شاه القاجاريّ (1807 ـ 1851م)([491]).
شخصيّات رئيسيّة في مسرح التعزية
كان السلاطين في العصرين الصفويّ والقاجاريّ يشرفون بأنفسهم على مسرح التعزية إنتاجاً وإخراجاً، وكانوا يرعونه رعاية تامّة، ويُنفقون عليه أموالاً طائلة. ولهذا كان السلاطين يبحثون عن أفضل الشخصيّات المسرحيّة؛ لينيطوا بهم مسؤوليّة إنتاج وإخراج مسرح التعزية.
اشتهر عدد من الأشخاص في العصرين الصفويّ والقاجاري بإشرافهم الكامل على إخراج مسرح التعزية، وأُطلق عليهم لقب (معين البكاء) أو(تعزيه گردان) وهو الشخص الذي یقوم بإدارة مجالس التعزية، فمَن كان يُلقّب بهذا اللقب كان يُشرف على إخراج مسرح التعزية؛ نظراً لتجاربه الطويلة ومعرفته بعناصر المسرح كافّة، وقدرته على تعيين الممثّلين والأشخاص الذين يؤدّون الأدوار، ولمعرفته بالآلات الموسيقيّة وإدارة المسرحيّة، أو إيقاف الممثّل عن التمثيل بكلّ حرفيّة.
معين البكاء الذي يقوم مقام المخرج في المسرح كان يعرف مهمّته معرفة كاملة، يعرف عمل كلّ واحد من الممثّلين، والفرقة الموسيقيّة، وكان يستخدم يده في إصدار الأوامر إلى الممثّلين، أو كان يرفع العصا ليأمر بعمل ما. كان معين البكاء يختار موضوع التعزية وملابس الممثّلين وألوانها، وإعداد ما يتطلّبه العرض من أدوات، والتنسيق بين الممثّلين وتحديد الألحان ومكان تواجد الآلات الموسيقيّة.
ففي الماضي كانت مهمّة معين البكاء أكبر من مهمّة المخرج في السينما والمسرح حاليّاً، لأنّ مخرج التعزية كان يعلم دقائق الأمور: «كان موسيقيّاً ويحفظ الألحان كافةً، يحفظ نسخ التعزية وكان عليه أن يعرف جيّداً أعضاء فرقته ويدرّبهم على أدوارهم، وأن يعلّمهم الألحان والأنغام والإيقاعات، وأن يكون لديه فهرس الممثّلين وما يجب أن يقوموا به، وإذا ما أضاع أحدهم نسخته فعليه أن يقدم له فوراً نسخة أخرى يحتفظ بها عنده، وأن يقوم بقيادة فرقته لحظة بلحظة»([492]). وفي عهد ناصر الدين شاه القاجاري أطلق الشاه على الأستاذ ميرزا محمّد تقي وهو من أهالي إصفهان لقب (معين البكاء) وأطلق على مساعده لقب (ناظم البكاء). وأطلق المختصّون بالتعزية على الميرزا محمّد تقي لقب (معين البكاء الكبير)([493]).
وعُيّن ميرزا باقر في منصب (معين البكاء) في تكية دولت. كما كان سيد مصطفى ميرعزا من المخرجين المعروفين لمسرح التعزية وهو من أهل كاشان. وفي عصر ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه انتقل إلى طهران، وقام بدور كبير في إنتاج مسرح التعزية([494]). يُضاف إلى اسم معين البكاء أسماء أخرى منها: ميرعزا (سيّد العزاء) وميرغم (سيّد الهمّ والغمّ).
من الشخصيّات الفعالة في مسرح التعزية (ناظم البكاء)، وهو يلي معين البكاء ويقوم ناظم البكاء بمساعدة معين البكاء في تنظيم المسرح، وإعداد ملابس الممثّلين وتعيين أماكنهم، وبدء الموسيقى وإيقافها، كما يقوم بتعيين أماكن الضيوف والمشاهدين في التكية([495]).
كانت الشخصيّات العاملة في المسرح تحظى باحترام الملك والسلطان والحاكم والأمراء والأشراف وكبار القوم والتجار في العصور الماضية، وتتلقّى الإكراميات والجوائز منهم.
هم من يمثّلون شخصية الإمام الحسين وأولاده وأنصاره الذين وصلوا إلى كربلاء، وحاصرهم جيشُ بني أميّة، وقطع عنهم الماء؛ لكي يستسلموا، ولكنّهم فضلوا الشهادة على الاستسلام والبيعة ليزيد بن معاوية، واستُشهدوا جميعهم في واقعة كربلاء([496]).
هم من يمثّلون شخصيّة يزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد والي يزيد على الكوفة، وقادتهما العسكريّين الذين جاؤوا إلى كربلاء على رأس جيوش كبيرة، وحاربوا الحسين وأهل بيته، وقتلوهم عن آخرهم، وسبوا أهل بيته، وأخذوهم إلى الكوفة ومنها إلى الشام([497]).
أدوات لا بدّ لها أن تتوافر في مسرح التعزية
مسرح التعزية يخلو من الزينة؛ لأنّ ذلك يساعد على تصوّر الصحراء القاحلة في كربلاء وقتل الحسين وأصحابه. ولكنّ المسرح يضمُّ أدوات لها دلالات عينيّة أو رمزيّة أو تزيينيّة: فعلى سبيل المثال الأدوات العينية مثل (السيف والرمح والراية) تزيِّن المسرح، كما أنّ وجود (طشت الماء وسَعَفة النخيل والطابوق) لها دلالات رمزيّة. الطشت يرمز إلى نهر الفرات، وسعفة النخيل ترمز إلى النخيل والبساتين، والطابوق يرمز الى الخرائب؛ حيث أُسكِن أهل بيت الحسين في خرائب الشام.
النصوص الشعريّة في عروض التعزية
عروض التعزية هي عروض شعريّة، وليست نثريّة، كما هو الحال بالنسبة إلى العروض المسرحيّة في أنحاء العالم. فالتعزية عبارة عن نصوص شعريّة مخصَّصَة لمناسبة خاصّة، ولكلّ عرض مسرحيّ اسم خاصّ به.
في بداية عروض التعزية كان الممثّلون الذين يقومون بأدوار الحسين وأصحابه وقادة جيش يزيد هواة غير محترفين، يقومون بأداء أدوارهم من أجل الحصول على الثواب، وليس من أجل كسب المال، كما هو الحال بالنسبة إلى العروض المسرحيّة، الّا أنّ العروض تطوّرت، وقام ممثّلون يجيدون أدوارهم بالوقوف على خشبة المسرح وتمثيل واقعة عاشوراء.
تطوّرت عروض التعزية مع مرور الوقت وأصبح الممثّلون يقومون بأدوارهم بصورة محترفة، وحفظ كلُّ واحد منهم ما يجب أن يقرأه من شعر، ولكن في بدايات عروض التعزية كان الممثّل يقرأ الشعر المخصَّص له من على ورقة صغيرة طولها 20 سنتيمترا وعرضها 5 سنتيمترات، يمسكها بيده. قراءة النصوص بقيت حتى اليوم، حيث يمسك الممثّل بورقة صغيرة مدوَّنة عليها أشعارٌ مخصّصة لدوره.
يرى العديد من المختصّين بمسرح التعزية أنّ الممثّل الذي لا يزال يمسك ورقة بيده لقراءة الأشعار يقوم بهذا العمل متعمّداً، ليتذكّر بأنّه يقوم بدور الممثّل، وليس هو الشخصيّة نفسها التي يقوم بتجسيدها.
كانت نصوص التعزية وما زالت نصوصاً بسيطة وسهلة، يفهمها عامّة الناس من أهالي المدن والقرى. وقد أصبحت النصوص على مرِّ الزمان أدبيّة سليمة اللغة. في مسرح التعزية هناك شخصيّة تقوم بدور المخرج، يُسمَّى (تعزية گردان) أي الذي يدير التعزية، وهو موجود على المسرح، يراقب الممثّلين ويذكّرهم بنصوصهم. كما أنّه يعلّم الممثّلين الصغار أدوارَهم والنصوص التي يجب أن يقرأوها.
هناك اختلاف في عدد نسخ نصوص التعزية الموجودة في إيران وفي المتاحف والمكتبات العالميّة، ونشير هنا إلى أهمّ ما توافر لدينا من معلومات عنها:
1) هنالك من يرى أنّ مجموعَها لا يتجاوز المائة نصّ، كما ذكر صادق همايوني في كتابه تعزيه وتعزيه خوانى (التعزية وقراءة التعزية) وعدَّد منها 99 نصَّاً([498]) ولكنّ السفير الإيطالي في طهران أنريكو چروللي Cerulli جمع في طهران بين العامَين 1950 و1955 لوحده 1055 نسخة من مجالس التعزية، وأهداها إلى مكتبة الفاتيكان([499]).
2) جمع ألكساندر أدمون خودزكو (خودزكو) chodzko المستشرق البولنديّ 33 نصَّاً، ونشرها في كتاب بالفرنسيّة، وهي موجودة حاليّاً في المكتبة الوطنيّة بباريس، وتُرجِم الكتاب إلي الفارسيّة وطُبع في طهران([500]).
تُعدّ نصوص خودزكو من أقدم نصوص مسرح التعزية، حيث نُظِّمت أواخر عصر الحاكم القاجاريّ فتحعليشاه (1212 ـ 1250هـ/1797 ـ 1835م).
3) نشر ويلهلم ليتن Litten في العام 1929م خمسة عشر نصَّاً من التعزية بالفارسيّة، وتعود النصوص إلى الأعوام 1834 و1838 و1839 و1840 و1910م.
4) نشر إدوارد براون 6 نسخ من نصوص مسرح التعزية بالفارسيّة، وهي موجودة الآن في مكتبة جامعة كمبريدج، ومطبوعة طباعة حجريّة.
5) أهدى كريمسكي مخطوطةً من نصّ مسرح التعزية، تعود للسنوات من 1896 إلى 1903 م إلى معهد اللغات الشرقيّة في موسكو. وقد احتفظ بهذا النصّ في مكتبة معهد العلاقات الدوليّة، ونُشر ضمن منشورات هذه المكتبة.
6) نقل السائح الروسيّ (إيليا نيكولايويج برزين) نسخةً تعزية مطبوعة طبعة حجريّة، تعود إلى سنة 1843م من إيران إلى روسيا، وهي أوّل طبعة حجريّة لنسخة من التعزية، ولا يُعرَف شيء الآن عن وجود هذه النسخة([501]).
تُرجمت نصوص مسرح التعزية إلي عدّة لغات. في ما يلي أهمّ الترجمات المتوفرة خارج إيران:
1) قام ألكساندر خودزكو بترجمة خمسة نصوص من مسرح التعزية من أصل 33 مجلس تعزية، بالفرنسيّة.
2) هناك ثمانية نصوص تُرجمت إلي الفرنسيّة منها نصوص مأخوذة من مجموعة 33 نصّاً من نصوص خودزكو، ونصوص مجهولة المصدر([502]).
1) ترجم لويس بلي في العام 1879م مجموعة مؤلّفة من 37 مجلس تعزية بالإنجليزيّة من دون أن تنشر النصوص الفارسيّة لهذه التعزيات.
2) ترجم أدوارد براون بالإنجليزيّة قسماً قصيراً من الطبعة الحجريّة من تعزية شهادة الحرّ بن يزيد الرياحيّ، وهي ضمن التعزية الخاصّة.
1) قسم من تعزية استشهاد الإمام عليّ.
2) بداية التعزية الأولى من مجموعة ليتن (كيف يذبح النبي إبراهيم ابنه إسماعيل قربةً إلى الله).
3) تعزيتان من مجموعة أنريكو جروللي. أورد المترجم النسخة الفارسيّة من التعزيتين.
4) أجزاء من شعر تعازي 1 ـ 9 من مجموعة ويلهلم ليتن([503]).
1) هناك نصوص للتعزية تُرجمت بالإيطاليّة تتضمّن عشرة مجالس تعزية من مجموعات أنریكو جروللی، وتضمّ 1055 نصَّاً.
2) تُرجمت التعزية الثالثة من مجموعة تعازي الكساندر خودزكو ال33 من الفرنسية إلي الإيطاليّة.
3) تُرجمت تعزية الحرّ بن يزيد الرياحيّ إلي الروسيّة من ضمن نصوص كريمسكي لسنة 1897م ([504]).
فرق مسرحيّة إيرانيّة تعرض التعزية
التعزية العاشورائيّة تحظى باهتمام المجموعات المسرحيّة في إيران، وهناك فرق عديدة متخصّصة بعروض التعزية العاشورائيّة، تقدّم عروضها المسرحيّة على المسرح أو في الهواء الطلق، وتُقام في بعض السنوات مهرجانات مخصّصة لعروض التعزية العاشورائيّة، حيث تقوم الفِرَق بعروضها، وتتنافس على كسب الجوائز المخصّصة لهذه العروض.
في سنة 2004م أُقيم أوّل مهرجان لعروض التعزية العاشورائيّة في طهران.
في سنة 2005 أُقيم ثاني مهرجان لعروض التعزية العاشورائيّة في طهران، وشارك فيه عدد كبير من الفِرق المسرحيّة التي قُدّمت عروضها للمشاهدين المتشوّقين لهذه العروض.
وفي ما يلي أسماء فِرق عروض التعزية العاشورائيّة التي تنشط في إيران وأسماء عروضها المسرحيّة التي قامت بعرضها على المسارح الإيرانيّة:
1- فرقة ماهان: قدّمت (قراءة 10 تعازي في شهر محرّم)....
2 ـ فرقة بيوند: قدمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان (الكوفيّون) عن وصول مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، وبيعة أهالي الكوفة له، وانفضاض الناس عنه واستشهاده.... كما قدّمت (قصّة الماء) حيث يقف العبّاس بن علي بن أبي طالب في كربلاء بالقرب من نهر الفرات، ويغترف منه ليشرب، ولكنّه يتذكر عطش أولاد الحسين ويسكب الماء في النهر....
3 ـ فرقه تئاتر كوچه [فرقة مسرح الزقاق]: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان (الكابوس الأحمر): يخفي خولي (من أصحاب يزيد) ليلاً، رأس الحسين بن علي في تنّور بيته، ولكنّه يرى في المنام كوابيس تقضّ مضجعه، وتشعر زوجاته بما يخفيه عنهن....
4 ـ فرقة سكوت: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان: (هل صحيح أنَّني قبّلتكَ في المنام؟)، يشعر الحرّ بن يزيد الرياحي عند مواجهة الحسين بن علي بالحيرة والحرج....
5 ـ فرقة نهال: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان (في ظلّ الصمت): تنقل إحدى خادمات قصر يزيد بن معاوية ما جرى للأسرى من أهل بيت الحسين في مجلس يزيد....
6 ـ فرقة نيايش: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان: (الذي قال لا، في ليلة ممطرة)، يدخل رجل غريب إلى داخل دير صغير وبعيد. الراهب يرى بأنّ الرجل الغريب يحمل معه شيئاً غالياً وثميناً.
7 ـ فرقة نهال: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان (فصل آخر): في یوم عاشوراء عندما يُنقل الأسرى، يبحث جندي عن قائده ويراه قد فقد بصره، يتبيّن أنّه كان يريد أن يؤذي أهل البيت، ولكنّه يُصاب بالعمى؛ لأنَّ زينب أخت الحسين دعت عليه....
8 ـ فرقة شهريار: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان: (شير علي)[الأسد عليّ]: منذ سنوات يتمنّى رجل وامرأة أن يكون لهما طفل، فينصحهما رجلٌ بأن ينذرا إذا رُزقا بطفل أن يؤدي دور الشمر (قاتل) الحسين، فيقومان بذلك، ويرزقان بطفل يُطلقان عليه اسم (شير علي)، ويصبح ممثّلاً يؤدّي دور الشمر...
9 ـ فرقة هسنيج: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان (طوفان البقاء): يعتزم رجل التوجّه إلى مدينة كربلاء، وفي الطريق يصادف رجلاً آخر، وتحدث وقائع...
10 ـ فرقة مهر وماه: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان (صوت الريح): الزبير ينتظر فرصة؛ لكي ينتقم من الحسين ظهر عاشوراء...
11 ـ فرقة الكوثر: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان (واقعة في الواقعة): يعتزم عدد من الإيرانيّين التوجّه إلى الكوفة لمبايعة الإمام الحسين، يصلون إلى مقبرة فيها رجل وامرأة يمنعانهم من التوجّه إلى الكوفة...
12 ـ فرقة آيين، قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان: (المثنوي الأحمر): نظرة إلى تعزية الحرّ بن يزيد الرياحيّ....
13 ـ فرقة جعبه سياه: قدّمت عرضاً مسرحيّاً بعنوان: (قلبي يهوى معجزة)، عجوز محترف في النواح على الحسين، يُصاب بسرطان الحنجرة، يجبره أفراد عائلته على التوجّه إلى بريطانيا للعلاج...
14 ـ فرقة تجربه، قدّمت عرضاً لمسرحيّة (دفتر الأمل)، سياوش يرغب أن يؤدِّي دور العبّاس بن علي في مسرحيّة التعزية، يصل إلى مبتغاه وينال الشهادة...
15 ـ فرقة بامداد، قدّمت عرضاً لمسرحيّة: (أيام مضت بذكرك)، بعد واقعة عاشوراء وعودة أهل البيت من الشام إلى المدينة، تذهب أمّ البنين والدة العبّاس بن علي إلى باب المدينة، وتنتظر عودة ابنها...
16 ـ فرقة آیین: قدّمت عرضاً لمسرحيّة (مسافرو الكوفة)، قافلة أسرى أهل البيت تتحرّك نحو الشام وتتوقّف في الكوفة، يخرج محمّد وإبراهيم ولدا مسلم بن عقيل من القافلة للبحث عن أبيهما، ويصادفان رجلاً يسألانه عنه، ولكنَّ الرجل الكوفيّ يطردهما كما طرد أهل الكوفة أباهما...([505]).
عروض مجالس التعزية العاشورائيّة على المسرح الإيرانيّ
تضمّ عروض التعزية العاشورائيّة مسرحيّات يُطلق على كلّ منها (مجلس عزاء). فكلّ مجلس عزاء له قصّة مستمدّة من أحداث عاشوراء، والمعركة الدائرة بين الحسين وأتباعه وجيش يزيد بن معاوية. مجالس العزاء دُوِّنت منذ قرون عديدة وبقيت حتّى وقتنا الحاضر، ويقوم المسرحيّون باقتباس قصص عاشوراء منها وتمثيلها على المسرح. مجالس العزاء كثيرة نقلها السيّاح الأوروبيّون، وأودعوها في المتاحف الأوروبيّة وترجموها بمختلف اللغات.
من مجالس التعزية العاشورائيّة ما له مصدر تاريخيّ معقول، ومنها ما هو من نسج الخيال. ومن أهمِّ مجالس التعزية العاشورائيّة التي مُثِّلت على المسرح الإيرانيّ حتىّ الآن ما يلي:
1ـ مجلس تعزية شاهچراغ: يصل كلّ من أحمد بن الإمام موسى الكاظم وإخوته مير محمّد وعلاء الدين وإبراهيم من المدينة المنوّرة إلى مدينة شيراز، للقاء أخيهم الإمام على بن موسى الرضا الذي یسكن في خراسان، في الوقت نفسه يصدر المأمون أمراً باعتقال من يرونه من بني هاشم. ينزل الإخوة الأربعة لأداء الصلاة خارج مدينة شيراز، ولكنَّ والي شيراز (قتلق) يبلغ بوصول هؤلاء إلى شيراز، فيرسل إليهم رسولاً يخبرهم بضرورة العودة إلى المدينة؛ لأنّه مأمور بالقبض عليهم إن أرادوا أن يذهبوا إلى خراسان. لم يستجب هؤلاء لكلام الوالي، فتحدث معركة بين الجانبين يُهزَم على إثرها الوالي، ويقرّر الجانبان التصالح، ولكن في اليوم التالي يأتي خبر من خراسان باستشهاد الإمام علي بن موسى الرضا. وهنا يحدث قتال من جديد بين الإخوة الأربعة ووالي شيراز حيث يبلي الإخوة بلاءً حسنا، وفي نهاية المعركة يستشهد الإخوة الأربعة ويدفنون في شيراز، ولا يزال مرقد الأخ الأكبر أحمد بن موسى الملقّب بـ(شاهچراغ) قائماً في مدينة شیراز، ویزوره محبّو أهل البيت.
2ـ مجلس تعزية فضل وفتّاح: فتّاح أحد أُمراء ما بين النهرين ووالده سلطان، استولى عمّه على ملك أبيه ووعده بأن يزوجه ابنته. يذهب فتّاح إلى عمّه ويطلب يد ابنته. ولكنَّ عمَّه الذي لا يريد تزويج ابنته لابن أخيه يقبّله، ويقول له بأنّ مهر ابنته هو أن يأتي برأس علي بن أبي طالب. ويضيف: عندما تأتي برأس علي بن أبي طالب سوف أزوّجك ابنتي. يتوجّه فتاح مع ابن عمّه فضل ومجموعة من المقاتلين إلى المدينة. وقبل وصولهم المدينة يرى فتاح فلاحاً يقوم بزرع نخلة، يذهب إليه ويسأله عن عليّ بن أبي طالب، يسأله الرجل عمّا يريد من عليّ، يجيبه فتّاح بأنه يريد منازلته، وأخذ رأسه إلى عمّه إشكبوس. يقول له الرجل بأن عليّا يشبهه، فإذا أراد أن ينازل عليّاً فعليه أن ينازله، وإذا ما تغلّب عليه كأنّه تغلّب على عليّ. يفرح الشاب ويقول للرجل بأنني سأكون محظوظاً إذا كان عليٌ مثلك. لأنّك ضعيف البنية ومن السهولة أن أتغلّب عليك، وسوف أصل إلى مبتغاي. يبدأ فتّاح منازلة الرجل، ولكنّهُ يُهزَم ويقول له الرجل بعد أن تغلَّب عليه: أنا عليّ بن أبي طالب، فحزّ رأسي؛ لتنال مبتغاك، يخجل فتاح من شجاعة عليّ ونبله ويقول له: أرجوك أن تقتلني أو أن تجعلني مولى لك حتى آخر العمر، ولا تبعدني عنك. يقبل عليّ الشرط الثاني ويغير اسم فتّاح إلى (قنبر)([506]).
3ـ مجلس تعزية مسلم بن عقيل: يرسل أهل الكوفة رسائل كثيرة إلى الإمام الحسين بن علي، يطلبون إليه أن يأتي إلى الكوفة، وأن يتولّى قيادتهم. يرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة نيابة عنه. يستقبله هاني بن عروة ويبايع أهالي الكوفة مسلماً في المسجد. يكتب مسلم رسالة إلى الحسين ويطلعه على مبايعة أهل الكوفة له. من جهة أخرى يدخل عبيد الله ابن زياد الكوفة والياً جديداً عيّنه يزيد، ويطلب إلى الكوفيّين أن يخبروه بمكان مسلم، ويتسلّموا منه جائزة. بعد أيام يُلقى القبض على هاني بن عروة ويُودع السجن. مسلم بن عقيل يخرج من بيت هاني ويلوذ ببيت امرأة صالحة تُسمَّى طوعة. ولكنَّ ابن طوعة يخبر ابن زياد بمكان مسلم بن عقيل؛ طمعاً بالجائزة. يرسل والي الكوفة الأشعث للقبض على مسلم في بيت طوعة، ولكنَّ مسلماً يواجه الأشعث وتدور معركة بينهما، وفي النهاية يُلقى القبض على مسلم، ويُنقل إلى قصر ابن زياد. يطلب ابن زياد إلى مسلم بن عقيل أن يتعاون معه، ويرضخ له، ويكفّ عن القتال، يرفض مسلم ذلك، عندها يصدر ابن زياد أمراً بقتل مسلم، ويُنفَّذ الأمر، ويُستشهَد مسلم.
4ـ مجلس تعزية الحرّ بن يزيد الرياحيّ: الحرّ بن يزيد الرياحيّ أحد القادة العرب الشجعان، يتلقّى أمراً من والي الكوفة عبيد الله بن زياد بملاحقة الحسين بن علي ومراقبته. الحسين يرى جيش الحرّ، ويكلّف أخاه العبّاس أن يسأل قائدهم عن هدفهم من تعقبه، يذهب العبّاس إلى الحرّ ويسأله عن هدفه، ويطلع الحسين على مهمة الحرّ، الذي كلّفه عبيد الله بن زياد أن يراقب الحسين وأصحابه ورغبة الحرّ في لقاء الحسين. فالحسين يدعو أصحابه بالسماح لجيش الحرّ بأن يدخلوا المشرعة، ويحملوا ما شاؤوا من الماء. الحرّ يلتقي الحسين ويصلّي جنوده وراء الحسين، ولكنَّ الحوارَ مع الحرّ لا يفضي إلى نتيجة. يرسل عبيد الله بن زياد الآلاف من الجنود بقيادة شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد لمساعدة الحرّ في القضاء على الحسين. ولكنَّ الحرّ يتراجع عن محاربة الحسين، ويلتحق هو وأخوه وابنه بمعسكر الحسين، ويكون أوّل شهداء كربلاء.
5ـ مجلس تعزية وهب النصرانيّ: يعبر وهب بن عبد الله الكلبي برفقة أمِّه وزوجته صحراء كربلاء في العاشر من محرّم. تقول أمُّ وهب لابنها: عليك أن تنصر الحسين، ولا تدعِ الشهادة تفوتك بين يدي الحسين.
يقول وهب لأمّه: وماذا أفعل بعروسي؟ تقول له أمّه: اِذهب وودّع عروسك في الخيمة، وأذهب لنصرة ابن رسول الله؛ ليكون حليبي حلالاً عليك.
يذهب وهب ليودّع عروسه ويطلب إلیها أن تسامحه؛ لأنّه حان وقت استشهاده. تطلب عروسه منه أن يأخذها إلى خيمة الحسين؛ لتكون بعده في أمن وأمان، وتقول له بأنّ لديها شرطاً تريد أن تطرحه على الحسين. يتوجّه وهب إلى الميدان ويقاتل الأعداء ويقتل منهم جمعاً غفيراً، ويعود إلى اُمّه وهو مضمّخ بالجراح، ولكنّ أمّه تشجّعه على العودة إلى ميدان المعركة، ويذهب من جديد ويقاتل الأعداء وينال الشهادة.
6ـ مجلس تعزية القاسم بن الحسن: يشارك القاسم بن الحسن بن عليّ في المعركة إلى جانب عمّه الحسين بن عليّ، وهو يقدّم العون لعمّه الذي يقف وحيداً بلا ناصر ولا معين في مواجهة جيش الكوفة والشام. يتوجّه القاسم إلى ميدان المعركة من دون أن يلبس ملابس الحرب، ويقاتل الأعداء ويقتل الأزرق الشامي وأولاد الأزرق، ولكنّ جنود العدو يحيطون به من كلّ جانب، ويقتلونه وبعدها يدوسون جسده بحوافر خيولهم.
7ـ مجلس تعزية عليّ الأكبر: عليّ الأكبر هو ابن الحسين بن عليّ، وهو أشبه الناس بالرسول محمّد|، وأمّه ليلى بنت أبي مرة. وتذكر الروايات أنّ عمره كان 18 عاماً وهو في عزّ الشباب، وقد دخل المعركة وأصيب بجروح على يد رجل يُدعى منقذ، ولكنّ الأعداء هاجموه وقتلوه في ميدان المعركة.
وصل الحسين في آخر لحظات حياة عليّ الأكبر، وأخذ رأسه ووضعه في حجره وقال: على الدنيا بعدك العفا. بعدها ينقل الحسين جسد ولده عليّ الأكبر إلى المخيَّم، ويعود إلى الميدان وقلبه حزين على ولده الشهيد.
8 ـ مجلس تعزية أبي الفضل العبّاس: أبو الفضل العبّاس هو ابن علي بن أبي طالب، وأخو الحسين بن علي، كان له دور كبير في معركة كربلاء، حمل راية الحسين، وتولّى سقاية أطفال الحسين، واستُشهد يوم عاشوراء. سمع الإمام الحسين صوت أخيه وهو يطلعه بأنّ الأعداء قطعوا يديه. يصل الإمام الحسين في اللحظات الأخيرة من حياة العبّاس ويراه وقد غرق في دمه، يضع رأس أخيه في حجره ويقول «يا أخي، الآن انكسر ظهري». يفتح العبّاس عينيه ويقول للحسين: «لا تنقلني إلى المخيَّم طالما أنا حيّ؛ لأنّني أخجل من سَكينة؛ لأنّها تنتظرني لأنقل إليها الماء». لُقَّب العبّاس بعدة ألقاب منها: باب الحوائج، حامل راية الحسين، سقّاء نينوى، وقائد جيش الإمام الحسين.
9ـ مجلس تعزية سوق الشام: زَيَّنوا مدينة دمشق، ووقف الناس على قارعة الطريق في صفين متقابلين بين باب المدينة وقصر يزيد بن معاوية، ينتظرون دخول السبايا ورؤوس شهداء كربلاء، فرحين ضاحكين، نقلوا الأسرى إلى قصر يزيد، ويظهر يزيد ارتياحه، يقف الإمام عليّ بن الحسين الملقّب بالسجّاد أمام يزيد، ويُلقي خطبة عصماء. يزيد بن معاوية يغضب من عليّ بن الحسين ويأمر بقتله، ولكنَّ زينب أخت الحسين تتدخّل وتُلقي خطبة في مجلس يزيد، تُدهش الحاضرين بفصاحتها وبلاغتها وحجّتها، ويتغيّر حال العديد من الحاضرين. يُجبَر يزيد على إرسال الأسرى إلى خرائب الشام، ليُرسَلوا في اليوم التالي إلى المدينة.
10ـ مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين: يدعو أهل الكوفة الحسين بن علي للمجيء إلى الكوفة ليكون قائداً عليهم. يقطع عبيد الله بن زياد والي الكوفة الطريق على الحسين، ويرسل جيشاً إلى كربلاء؛ لإجبار الحسين على البيعة أو قتله. الحسين يرفض البيعة ليزيد، تبدأ المعركة ويُقتل جميع أصحاب الحسين في المعركة، الحسين ظلّ وحيداً، يودّع أخته زينب ويتوجّه نحو الأعداء ويقاتلهم، وأخيراً يُستشهَد في الميدان([507]).
الفصل الثاني
دراسة مقارنة لثلاث مسرحيّات عاشورائيّة
نظم الشعراء في العديد من البلدان العربيّة والإسلاميّة واقعة كربلاء واستشهاد الحسين وأنصاره وأهل بيته على شكل مسرحيّة شعرية، عُرضت على خشبة المسرح في العديد من البلدان الإسلاميّة، وكان الإيرانيّون أوّل من كتب مسرحيّة عن استشهاد الحسين وأصحابه وأهل بيته، تناولوا واقعة كربلاء على شكل عمل مسرحيّ شعراً، ويعود ذلك إلى العهد الزندي؛ أي منتصف القرن الثاني عشر للهجرة.
انتقل مسرح التعزية بذكرى عاشوراء من إيران إلى لبنان في أوائل القرن العشرين، وأخذ اللبنانيّون يقيمون مسرح عاشوراء في مدينة النبطيّة، واستمرّ عرض المسرحيّة حتى الآن، وكانت أوّل مسرحيّة شعرية كُتبت في مصر في منتصف القرن العشرين، كتبها الشاعر المصري عبد الرحمن الشرقاويّ، وأسماها (الحسين ثائراً وشهيداً) وقد مُثّلت على المسرح، ولكن مُنع عرضها لأسباب نذكرها في حينها.
مسرحيّة استشهاد الإمام الحسين كُتبت شعراً على يد شعراء إيرانيّين مجهولين لم يذكروا أسماءهم، وهناك نسخٌ متعدّدة من المسرحيّة نظمها شعراء عديدون، ومُثِّلت على المسرح منذ قرنين، وكان السيّاح الأوروبيّون قد ذكروا تفصيلات المسرحيّة في كتبهم التي كتبوها عن رحلاتهم في إيران. نُقلت نصوص مسرحيّة (استشهاد الإمام الحسين) عن كتاب (روضة الشهداء) بالفارسيّة، والذي كتبه الملا حسين واعظ كاشفي، ويُعدُّ من كتب المقاتل ـ كما ذكرنا سابقاً ـ ولكنَّ مسرحيّة عاشوراء التي تُمثَّل على خشبة المسرح في مدينة النبطيّة في لبنان يوم عاشوراء أخذت نصوصها من كتاب للسيد محسن الأمين([508]). أمّا مسرحيّة الحسين ثائراً وشهيداً التي نظمها الشاعر المصريّ عبد الرحمن الشرقاوي وعرضت على المسرح في مصر فقد نُقلت عن كتب التاريخ والمقاتل، ولم يذكر الشاعر كتاباً بعينه، بل أشار إلى أنّه أخذ أحداث المسرحيّة من المصادر التاريخيّة.
1 ـ مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين ×
مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين× الذي نحن بصدد دراسته عرض مسرحيّ يقام على المسرح في مدينة دربند سر التي تبعد 50 كيلومتراً عن العاصمة الإيرانيّة طهران، ويشارك فيه خمسة عشر شخصاً يمثّلون: الإمام الحسين والسيّدة زينب بنت علي، والإمام علي بن الحسين، والملاك الأوّل والملاك الثاني، والسلطان قيس، والدرويش وزعفر الجني، والأعرابيّ، وسكينة بنت الحسين، ووزير السلطان قيس، وعبد الله، والسيدة فاطمة الزهراء، وعمر بن سعد، وشمر بن ذي الجوشن.
كما تُستخدَم في العرض أدوات منها: قربة ماء، ومروحة يدويّة، وسرير نوم، وطبر (فأس)، وكشكول (جراب) الدراويش، وجلد الأسد، وأدوات الحرب، والدمّام، والمزمار، وأشخاص يمثّلون دور الجنود، وسرير طفل.
أغلب كتّاب وناظمي مجالس التعزية في إيران مجهولون؛ لأنَّ الذين كتبوها لم يذكروا أسماءهم لأسباب عديدة، منها عدم رغبتهم في أن يُعرَفوا، والسبب الثاني كونهم كانوا يكتبون مجالس التعزية للحصول على الثواب، وقد مرَّ ذلك فيما سبق.
لم نَرَ أيّاً من مجالس التعزية التي جمعها الإيرانيّون أو السيّاح الغربيّون والمحفوظة حاليّاً في بطون الكتب، أو في المتاحف الإيرانيّة والعالميّة، قد كُتِب اسم كاتبها أو الشاعر الذي نظمها، لا سيّما وأنَّ مجالس التعزية جميعها نُظمت شعراً. ولكنَّ كتب التاريخ والأدب أشارت إلى أنَّ أمير كبير رئيس وزراء ناصر الدين شاه القاجاريّ([509]) أصدر تعليمات إلى أمير الشعراء في عصره الميرزا نصر الله الإصفهانيّ الملقّب بـ(شهاب) بنظم اثني عشر مجلساً للتعزية بأسلوب متين يفهمه الخواصّ والعوامّ، بعد أن كانت الأشعار التي نُظمت بها مجالس التعزية ضعيفة الأسلوب، وكثيرة الأغلاط. قام الشاعر بنظم مجالس التعزية بأسلوب شعريّ عاطفيّ، يجعل مستمعيه يذرفون الدموع، ولو كانت قلوبهم أقسى من الحجر([510]).
نُظمت نصوص مجالس التعزية بأشعار مفهومة لمن يقرأها، وهناك اختلاف بين مجلس تعزية وآخر. وقد أدّى تنقيح الأشعار إلى تسهيل قراءتها وفهمها من العامّة. فبعض الأشعار بسيطة جدّاً ومفهومة لعامّة الناس، وبعضها ضعيفة نظمت؛ ليفهمها الناس العاديّون، لا سيّما القرويّون منهم.
تظهر دراسة هذه الأشعار للدارس الخصائص الاجتماعيّة والثقافيّة واللغويّة والأدبيّة والفنيّة لعناصر التعزية في إيران. ويرى جامعو نصوص (مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين) بأنّها تعود إلى قبل مائة وخمسين عاماً تقريباً، وهذا ما يجعل هذه النصوص تشبه من حيث التوقيت مجموعة نصوص التعزية ال 33 التي جمعها الكساندر خودزكو (خوجكو) المستشرق البولنديّ، ونشرها في كتاب بالفرنسيّة، وهي موجودة حاليّاً في المكتبة الوطنيّة بباريس، وتُعدّ نصوص خودزكو من أقدم نصوص مسرح التعزية، نُظمت أواخر عصر فتحعلي شاه القاجاريّ (1212ـ 1250هـ/1797 ـ 1835م)([511]).
وعند قراءة مجلس تعزية الإمام الحسين نرى أنّ المجلس يتضمّن أدواراً لشخصيّات عديدة مضافة، لم تُشر إليها المقاتل، ولم تتناولها نصوص (مسرح التعزية في النبطيّة) و(مسرحيّة الحسين ثائراً وشهيداً) بقلم عبد الرحمن الشرقاوي، وهذه الشخصيّات هي: الملاك الأوّل، والملاك الثاني، والسلطان قيس، والدرويش والأعرابي، وسكينة بنت الحسين، ووزير السلطان قيس، بينما لم تتضمّن مجموعة خودزكو شخصيتي (السلطان قيس والدرويش). ويبدو أنّ هاتين الشخصيّتين أضيفتا لاحقاً إلى مجلس التعزية.
أصول مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين×
لا شكّ أنّ ناظم أو ناظمي (مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين) استند في نظم مجلس التعزية إلى أصول فارسيّة، وأغلب الظنّ أنّ كتاب (روضة الشهداء) لمؤلّفه ملا حسين واعظ كاشفي هو أهمّ مصدر اعتمد عليه ناظم مجلس التعزية كما اعتمد عليه الخطباء والمنشدون في ذكر مصيبة الحسين.
نرى أنّ أوّل عبارة ذكرها ناظم مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين، هو كلامٌ لشمر بن ذي الجوشن، أحد قادة جيش عبيد الله بن زياد، والي يزيد بن معاوية على الكوفة، يدعو فيه جيشه لأنّ يكون فرحاً طرباً؛ لأنّه يريد قتال الحسين وأصحابه، ويرى بأنّ الحسين الذي يصفه بابن ساقي الكوثر، وابن فاطمة الزهراء يشكو العطش؛ بسبب قطع الماء عنه وعن أهل بيته، في حين أنَّ مؤلِّف كتاب روضة الشهداء يشير إلى أنَّ عبيد الله بن زياد أناط بعمر بن سعد بن أبي وقّاص مهمّة محاربة الحسين واعداً إيّاه بولاية الريّ وطبرستان؛ مغدقاً عليه المال؛ لكي يقتنع بمحاربة الحسين، كما يشير إلى دور شمر بن ذي الجوشن في واقعة كربلاء([512]).
يسأل الحسين بن علي أعداءَه ويقدم نفسه إليهم، ويذكّرهم بمكانته الروحيّة ويقول: «يا قوم هل تعرفونني؟ هل تعرفون أصلي ونسبي؟ أنا مفخرة سلالة الخليل، أنا مخدوم جبريل، نور وجه الشمس والقمر، إنّني وجه السماء الوضّاء، ولو أنّ العرب، يعاملوننا كالتتار، إنّني غريب هذه الديار، إنّني أواجه الجفاء، إنّني ابن نبيكم». ولكنّ شمر بن ذي الجوشن يردّ عليه بالقول: «يا حسين إنّ جدّك هو نبينا وهو زعيمنا وقائدنا، لكنّني اليوم أطيع أمر يزيد وعليَّ أن أقطع رأسك». ويقول الإمام الحسين: «إن هاجرتُ من يثرب والبطحاء وابتعدت عن أرض العرب، سأذهب إلى حيث لا حديث ولا حوار وأترك هذا الملك لك يا وغد». يجيبه ابن سعد: «غير مسموح لك أن تذهب إلى الإفرنجة ولا إلى روضة النبي المصطفى، عليك أن تختار أحد السبيلين، إمّا أن تبايع يزيد، أو تدخل غمار الحرب، ولكنَّ البيعة لابن زياد ويزيد أفضل حتى لا يكون مصيرك القتل».
يحفظ كلّ ممثّل دوره بصورة جيّدة، فالممثِّل الذي يمثّل دور الحسين له الدور الرئيسيّ في العرض المسرحيّ، كذلك من يمثّل دور الأشقياء لا سيّما عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن. الممثّلون يقومون بأدوارهم بحسب ما كُتب لهم، ويقوم المخرج بتنسيق الأدوار، ويشير إلى كلِّ ممثّل عندما يأتي دوره.
يُقام مسرح التعزية على خشبة المسرح، سواء كان في المدن الإيرانيّة أو في العاصمة طهران، كما أنَّ العديد من الممثّلين يقومون بتمثيل المسرحيّة في الهواء الطلق خارج مسرح المدينة في طهران([513])، حيث إنَّ المسرح مكان ليس محدوداً لا في مساحته ولا في شكله، بل هو حرّ من كلّ قيد أو فرض، وهذه الطريقة تضمن للمسرح عدم ابتعاده عن الجمهور.
أحد مقوِّمات مسرح التعزية هو الشعر، فالشعر يُعدّ وسيلة تعبير ولا يكون المسرح ناجحاً إذا خلا من الشعر.
لما نزل القوم في كربلاء وحطّوا الرحال ناحية الفرات، وضُربت خيمة الحسين لأهله وبنيه وبناته، وضُربت خيم إخوته وبني عمّه حول خيمته، وجلس الحسين في خيمته يشحذ سيفه، وبجانبه (جون) مولى (أبي ذر الغفاري)، وهو يقول:
|
يا دهر أفٍّ لكَ من خليل |
يعشق الإيرانيّون مسرح التعزية، سواء أقيم المسرح في المدينة أو في القرية، ويتجاوب المشاهدون مع الممثّلين، لا سيّما الذين يؤدّون أدوار الحسين وأهل بيته، وكثير من المشاهدين يحفظ مقاطع من المسرحيّة. والممثّلون الذين يقومون بأدوار الأشقياء؛ أي قادة جيش يزيد كشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، يقومون بأدوارهم مكرَهين، وكثير منهم نراهم يتعاطفون مع الحسين، حتى عندما يؤدّون دور شمر أو عمر بن سعد أو يزيد، ويذرفون الدمع على الحسين بينما يلبسون ملابس الشمر وعمر بن سعد.
إخراج مسرح التعزية يرتبط بمخرج المسرح، أو رئيس الفرقة الذي يقوم بالتنسيق بين الممثّلين. ويُطلَق على مخرج التعزية في إيران أسماء عِدّة، منها: استاد [الأستاذ]، وتعزيه گردان [مدير التعزية]، وتعزيه خوان [قارئ التعزية] وشبيه گردان [منسّق الشَّبيه] ومعين البكاء، وناظم البكاء، وميرعزا [أمیر العزاء]، أو گره گشا أو مشكل گشا (حلّال المشاكل).
لغة المسرح هي الفصحى، وأغلب الظنّ أنّ الممثِّل، اقتبس نصّ المسرحيّة من كتاب (روضة الشهداء) من تأليف الملا حسين واعظ كاشفي. ولكنْ أُجريت تعديلات على نصوص مسرح التعزية بمرور الوقت.
عند إجراء مسرح التعزية يرتدي الممثِّلون ملابس أُعدَّت لهم مسبقاً، فلباس الأولیاء أي الحسين وأهلُ البيت هو اللون الأخضر، والأشقياء من قادة جيش يزيد ابن معاوية أي الشمر وعمر بن سعد وجنود الجيش الأمويّ يلبسون اللون الأحمر والأصفر والأزرق. وتُغطّى جدران المسرح باللون الأسود، الذي يمثِّل الحزن على الحسين، وهو اللون الذي يلائم الأولياء من أهل بيت رسول الله.
مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين الذي يمثَّل في إيران على خشبة المسرح، أو في البيوت والحسينيّات والمساجد، لم يُكتَب كما كُتبت مسرحيّة عاشوراء التي تُمثَّل في مدينة النبطيّة في لبنان بحسب تسلسل الأحداث يوم عاشوراء، بل إنّ مجلس تعزية الإمام الحسين يستعرض مواقف كلّ طرف من الطرف الآخر، فشمر بن ذي الجوشن يدعو أنصاره وجنوده إلى الطرب والفرح بسبب محاربتهم لأهل بيت رسول الله. وهنا يجري الحوار بين شمر والحسين بن علي، فالحسين يردّ على الشمر ويلعنه بسبب موقفه منه وهو ابن رسول الله، يسأله إن كان يعرفه ويعرف أباه وأمّه، ويقسم الحسين بأنّه لا حفيد لرسول الله غيره، والحسين يقول لشمر بن ذي الجوشن بأنَّ ابن زياد يمنحه الريّ وجرجان إذا ما قام بقتله، ويضيف الحسين «بأنَّك إن فعلت ذلك فلن تهنأ ولن تفرح في الدنيا والآخرة، وأرى رأسك معلّقاً على أبواب الكوفة والأطفال يقذفونه بالحجارة».
ويخاطب الحسين أصحابه ويقول لهم: «لم أرَ أصحاباً أوفى منكم، ولا أهل بيت مثل أهلي بيتي، جزاكم الله خير الجزاء». ثمّ يطلب الحسين من أصحابه التفرّق مستفيدين من سواد الليل، ويقول بأنّ الأعداء لا يطلبون غيره. ولكنّ أصحابه يصرّون على البقاء ومحاربة الأعداء، عندها يرفع الحسين يديه إلى السماء ويدعو ربّه أن يغفر لأصحابه.
ومن قادة جيش يزيد يتحاور شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد، وكلّ منهما يَعِدُ الآخر بما سوف يقدّم لهما يزيد وعبيد الله بن زياد من مغانم، ومنها تنصيبهما حاكمين للرَّي وطبرستان إذا تمكّنا من إجبار الحسين على البيعة ليزيد، أو قتله بسبب الامتناع عن مبايعته. ومن ثَمّ يجري حوار بين الحسين وأخته زينب يقول الحسين لأخته: إنّه سوف لن يتركها وحيدة بيد الأعداء، ولكنّه يطلب إليها أنْ تضع رأسه في حجرها ويغفو للحظات، ولكنّه بعد قليل ينتبه، ويقصّ على أخته زينب ما رآه في المنام، فقد رأى أمّه فاطمة، التي قالت له: إنّه سيكون ضيفاً عليها مساء الغد. وهنا يدعو الحسين أخته أن تصبر على المكاره والأسر. ويطلب إليها أنْ تأتي له بثوب عتيق، لا يرغب أحد بسلبه، ويقول بأنَّ الثوب العتيق هو لدفع حرارة صحراء كربلاء.
في مجلس تعزية الإمام الحسين حديثٌ مُتخيَّل بين اثنين من الملائكة والإمام الحسين، فالملاك الأوّل يخاطب الحسين بقوله: «ياحسين يا قتيلاً في سبيل الله، ياشهيداً قُتل بأيدي أهل الكوفة الذين لا حياء لهم، الأنبياء جميعم يبكون عليك، إنَّ في الجنة نهراً من لبن لعليّ والحسين والحسن».
ويخاطب الملك الثاني الحسين ويقول له: «يا ضياء عين خير النساء، يا قتيلاً في سبيل الله، نبكي عليك صباحاً ومساءً، إنّ في الجنة نهراً من لبن لعليّ والحسين والحسن». عندها، يلبس الحسين الكفن، ويعدُّ نفسه لقتال جيش يزيد، وينادي جدَّه رسول الله: «اين محمّد العربيّ ليرى حفيده، وهو يلبس الكفن ويستعدّ للشهادة»؟
ولكنَّ الجوهري في (طوفان البكاء) يسمّي أحد المَلاكَين باسم منصور، وينقل الحكاية على نحو آخر، إذ يقول إنَّ الملاك منصور، جاء إلى الحسين على رأس أربعة آلاف ملاك، وقال له: «يا ابن رسول الله! أرواحنا فداك، لقد جئنا لنقدّم لك العون والمساعدة تنفيذاً لأوامر الله، فأمرْنا لنحقن دماء أقربائك، فبكى الحسين، وأعطى الملاك رخصةً للعروج إلى السماء، وركب فرسه ذا الجناح، ووقف مقابل جيش ابن سعد وأخذ يرتجز ويقول([515]):
|
أنا ابن عليّ الخير من آل هاشم |
ثمّ يخرج الحسين إلى المعركة، ويخاطب جيش يزيد ويقول: «يا قوم هل تعرفونني؟ هل تعرفون أصلي ونسبي؟ إنّني مفخرة الخليل ومخدوم جبرائيل، نور وجه الشمس والقمر، إنّني نجم السماء، إنّني غريب هذه الديار، حفيد النبي المختار، بناتي عطاشى منذ تسع ليال ونهار، اِسقوني شربة من الماء، اِرحموني فأنا العطشان». وهنا يردّ عليه ابن سعد ويقول له: «يا حسين إن جدّك رسولنا وهو زعيمنا وقائدنا، ولكن علينا أن نحزّ رأسك، ونفصله عن جسدك نزولاً عند رغبة يزيد».
وهنا نلاحظ تحوير الحديث التاريخيّ الأساسيّ أو الكلام الذي قاله الإمام الحسين، ليجري على لسانه كلام فيه استجداء واستعطاف استدراراً لعواطف المشاهدين.
وهنا يطلب الحسين أن يسمحوا له بالذهاب بعيداً عن أرض العرب، ليعيش وحيداً لا يسمع القيل والقال، لتبقى الأرض والمال لابن سعد وقادة جيش يزيد. ولكنَّ ابن سعد يعارض توجّه الحسين إلى خارج كربلاء، إلى مدينة جدّه يثرب، ويخيره بين أن يبايع عبيد الله بن زياد ويزيد، أو أن يُقتل ويفقد حياته. وهنا يطلب ابن سعد من الحسين أن يودّع أهله وعياله، وأن يتفرّغ للقتال.
عندها يوصي الحسين أخته زينب بالصبر على المكاره وعدم الجزع وعدم شقّ الجيوب عليه إنْ قتل، ولكنّه لا يمنعها من البكاء عليه. وتخاطب زينب نفسها بالقول: «جاء الموت يا زينب وعليك التهيؤ له، فإذا أصبحت من دون الحسين فكيف سوف تعيشين غداً؟ انتهت حياة العزّة، ستكونين أسيرة بيد الأعداء، ستُضربين بالسياط وتؤخذين أسيرة إلى الشام، عليك بالصبر على البلاء، لقد أصبحتِ غريبة يا زينب، عليك أن تفكري بيوم غد».
نلاحظ هنا أيضاً أنّ الحسين
يخبر أخته بما سيحدث بعد مقتله، أيضاً
لإثارة مشاعر الجمهور.
بعدها يتوجّه الحسين بالكلام إلى ابنه المريض زين العابدين، ويدعوه أن يصبر لأنّه الوحيد الذي سيبقى بعد مقتل أبيه، وعليه أن يتحمَّل عبء الإمامة، وهنا يرى عليّ بن الحسين أباه وحيداً لا ناصر له ولا معين. ويطلب من أبيه الإذن لمقاتلة الأعداء، ولكنّ الحسين ينهاه عن ذلك؛ لأنّه مريض، ويوصيه بالنساء والأطفال ويودّعه.
يودّع الحسين أهله وعياله، ويوصي أخته بأن تتولّى الإشراف على عياله وأطفاله، بعد أنْ يُقتل ويُؤخذ عياله أسرى، ولكنَّ الحسين عند توجّهه إلى أرض المعركة يواجه زوجته شهربانو التي تطلب منه أن يأخذ طفلها الرضيع عبد الله ويسقيه شربة من الماء. وهنا يطلب الحسين من الأعداء شربة من الماء للطفل الرضيع، لكنَّ حرملة (أحد قادة الجيش الأمويّ) يوجِّه إلى الطفل الرضيع سهماً ذا ثلاث شعب يودي بحياة الطفل الرضيع.
يُدخل الإيرانيّون هنا زوجة الحسين الإيرانيّة في المسرح، وكأنّهم بشكل غير مباشر، يريدون إثبات القرابة بينهم وبين الإمام الحسين وأهل بيته، علماً أنّ التاريخ لا يقول بأنّ أمَّ عبد الله كان اسمها شهربانو.
والحسين عندما يرى نفسه وحيداً في أرض المعركة ينادي بأعلى صوته: «هل من ناصر ينصرني، هل من ذابٍّ يذبُّ عن حرم رسول الله». وفي المشهد الأخير يجري حوار بين الحسين والشمر الذي يجلس على صدره؛ يريد ذبحه.
أيضا نلاحظ أنّ هذا المشهد الإضافي المتخيَّل، يُقصَد منه الإثارة.فالحسين يسأل شمراً الذي يريد ذبحه من أنت؟ ويردّ عليه الشمر بأنّه الشمر، وبأنّ أباه ذو الجوشن، ويسأله الحسين: ألا تعلم من أنا؟ ويردّ عليه الشمر، بأنّ العالَم كلّه يعرف مقامك ومنزلتك، ويسأل الحسين الشمر: هل يعرف من هو أبوه وجدّه؟ ويردّ الشمر بأنَّ عليّاً أبوه ومحمداً رسول الله جدُّه. كما يسأله الحسين ألا يعرف أمّه فيردّ الشمر عليه بأنَّ فاطمة أمُّه. والحسين يسأل الشمر: لماذا يريد قتله؟ فيردُّ الشمر عليه، ويقول بأنّ سبب ذلك هو عداؤه لأبيه عليّ بن أبي طالب. الحسين يسأل الشمر: «ماذا ستربح إن ذبحتني؟»، فيردّ عليه الشمر بأنّه سوف يحصل على حكم الرَّي والموصل.
هنا نصل إلى قمة الحدث الغرائبيّ؛ إذ يطلب الحسين إلى الشمر إمهاله لحظات ليصلي صلاة الظهر، وعندما يقف للصلاة يناديه ابن سعد، ويقول للشمر إنَّ الحسين يصلي ويدعو عليه. ولكنَّ شمر بن ذي الجوشن في آخر مجلس التعزية يحزّ رأس الحسين، ويدعو الآخرين ليشهدوا له عند ابن زياد ليمنحه ملك الريّ وطبرستان. علماً أن عمر بن سعد هو الذي وُعِد بملك الريّ كما يقول التاريخ.
ومن الإضافات أيضاً وصول أعرابيّ إلى ساحة المعركة، ويلتقي الحسين، ويوصل إليه خبراً من ابنته فاطمة المريضة، التي بقيت في المدينة، وهي تعاني الفراق والبعد عن أبيها الحسين، ويجري حوار بين الأعرابي والحسين، وينقل الأعرابيّ ما تعاني منه فاطمة من ألم الفراق، ولكنَّ الحسين يخبر الأعرابي بحاله في أرض كربلاء، ويريد من الأعرابي أن يوصل رسالة منه إلى فاطمة، ويعلن لها أنَّه محاصر في كربلاء، غريب لا معين له، ويعدها باللقاء يوم القيامة. علماً أنّ النصَّ التاريخيّ يثبت وجود فاطمة بنت الإمام الحسين في كربلاء، وقد نقل السيد محسن الأمين كلاماً على لسانها.
وهنا يدخل درويش إلى أرض المعركة ويلتقي الحسين، ويخبره أنّه جاء من الهند وكابول وكشمير، وهو يطلب الإذن من الحسين ليدخل المعركة، ليواجه جيش الكفر ويدافع عن سيد الأبرار. هذه الزيادة تهدف إلى استدرار تعاطف المسلمين الهنود. وينادي الحسين في القوم ويقول: «هل من ناصر ينصرني؟». ويردّ عليه زعفر الجنّي وهو زعيم الجن، وقد جاء إلى أرض المعركة على رأس جيش من الجنّ لنصرة الحسين، ويطلب زعفر من الحسين أن يأذن له ليحارب فرقة الأشرار، ويقضي عليهم. ولكنَّ الحسين يقول له بأنّه قدِمَ إلى أرض المعركة، وأضاف الحسين: «لقد قدّمتُ ابنائي وأصحابي فداء للمحبوب». هذه العبارة من إضافات أهل العرفان. مضيفاً: «بأنَّ الدنيا لم تدم لرسول الله، فكيف لي أن أطلب الدنيا والخلود فيها، بينما استُشهد أولادي وأحبابي في أرض المعركة، ويطلب الحسين من زعفر الجني العودة من حيث أتى، والبكاء عليه».
وقصّة زعفر الجني التي وردت في (مجلس تعزية الإمام الحسين) منقولة من كتاب (روضة الشهداء) لمؤلفه الملا حسين واعظ كاشفي([517]). تقول الرواية: «إنَّ زعفر الجني زعيم الجنّ المسلمين، ترك مراسم عرسه، وجاء على رأس جيش إلى كربلاء لنصرة الحسين، ولكنَّ الحسين لم يقبل مساعدة الجن، هذه الرواية يرفضها العديد من علماء الشيعة، ومنهم آية الله مرتضى مطهري ويعدّها من تحريفات واقعة عاشوراء ومن الخرافات»([518]).
وردت هذه القصّة أيضاً في (بحار الأنوار) للمجلسي على النحو التالي: «وأتته أفواج مسلمي الجن فقالوا يا سيدنا، نحن شيعتك وأنصارك، فمرنا بأمرك، وما تشاء، فلو أمرتنا بقتل كلّ عدو لك، وأنت بمكانك لكفيناك ذلك، فجزاهم الحسين خيراً وقال لهم: أو ما قرأتم كتاب الله المنزل على جدي رسول الله (أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ) ([519])، وقال سبحانه: (لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ) ([520])، وإذا أقمت بمكاني فبماذا يبتلي هؤلاء الخلق التعساء وبماذا يُختبَرون؟ ومن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء؟ وقد اختارها الله يوم دحا الأرض وجعلها معقلاً لشيعتنا، ويكون لهم أماناً في الدنيا والآخرة، ولكن تحضرون يوم السبت، وهو يوم عاشوراء الذي في آخره أُقتل، ولا يبقى بعدي مطلوب من أهلي ونسبي وإخوتي وأهل بيتي، ويسار برأسي إلى يزيد لعنه الله».
فقال الجنُّ: «نحن والله يا حبيب الله وابن حبيبه، لولا أنّ أمرك طاعة، وأنّه لا يجوز لنا مخالفتك، لقتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك»، فقال صلوات الله عليه لهم: «نحن والله أقدر عليهم منكم، ولكن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من يحيى عن بينة»([521]).
وینقل الجوهري صاحب كتاب (طوفان البكاء) حكاية زعفر الجني والحسين، مع شيء من التفصيل، ويظهر ذلك أنّ الجوهري يؤيِّد حدوث مثل هذا اللقاء([522]).
وفي مجلس استشهاد الإمام الحسين يجري حوار بين السلطان قيس (أحد ملوك الهند) ووزيره([523]) حيث يُعلِم وزيره بأنَّه يشعر بضيق وكآبة، ويسأل وزيره عن اليوم الذي هم فيه، ويخبره الوزير بأنَّه سنة واحد وستين من الهجرة، هنا يُعرب السلطان عن خشيته على الحسين بن علي حفيد رسول الله، ولكنَّ الوزير يشير عليه بعدم التشاؤم، ويقترح عليه بأن يذهب إلى الصيد في الصحراء، من أجل أن يصطاد غزالاً، ولكنَّ الملك يواجه في الصحراء أسداً يهمّ بالهجوم عليه، فالملك يستغيث ويطلب العون من الحسين بن علي، والحسين يحضر عنده، وهو عطشان وجسمه أثقلته الجراح، وينقذه من الأسد الذي يخرّ راكعاً أمام الحسين، وهنا يسأل الملك الحسين عن وِجهته، ويخبره الحسين بأنّه يحارب أهل الكوفة في كربلاء، ويقترح الملك على الحسين أن يترك أرض كربلاء ويذهب معه إلى الهند، ولكنّ الحسين يرفض الذهاب إلى الهند، ويتساءل: «كيف يمكنه أن يغادر أرض المعركة، وقد استُشهد أولاده وأصحابه على هذه الأرض». ويقدّم الحسين للملك حفنة من تراب كربلاء، ويقول له إذا تحوّل التراب دماً، عندها أقم علينا النواح والعزاء[524].
وكون هذه القصّة من الخرافات المضافة لا يحتاج إلى أدلّة.
ونشير هنا إلى أنّ مجلس تعزية استشهاد الإمام الحسين يختلف عن مسرح عاشوراء في النبطيّة، وفي مسرح الحسين ثائراً وشهيداً لعبد الرحمن الشرقاوي شخصيات تشارك في المسرحيّة لا يوجد لها أي دور في المسرحيتين المذكورتين، وهي مستقاة من كتاب (روضة الشهداء) للملا حسين واعظ كاشفي، وهي شخصيّات أسطوريّة أو خرافيّة، كما يصفها الشيخ مرتضى مطهري في كتابه (تحريفات عاشوراء) وغیره من كبار العلماء والمؤرّخین الشیعة.
مسرحيّة استشهاد الإمام الحسين×
يُقام مسرح عاشوراء في النبطيّة بلبنان كلّ عام، ففي اليوم العاشر من المحرم تُتلى في الصباح الباكر على الملأ قصّة مصرع الإمام الحسين وأهله وصحبه في واقعة كربلاء، وسط البكاء والنحيب ولطم الخدود والجباه والصدور، ثم تُمثّل القصّة على مسرح في الهواء الطلق، يشاهده القادمون من بلاد قريبة أو بعيدة ومن أديان وأجناس مختلفة، ثم يعلو الضجيج والصراخ والتكبير والتهليل عند مصرع الحسين ويبدأ (الضاربون) من شيوخ وكهول وشباب وأطفال، ويُعَدّون بالمئات، بضرب رؤوسهم؛ للمبالغة في إظهار الأسف والأسى، والحزن على الحسين وفاجعته مع جميع أهله وصحبه من شهداء كربلاء الذين استُشهدوا بين يديه؛ في سبيل إحقاق الحقّ ومقاومة الظلم، ودفع الطغيان، وتثبيت دعائم الدين([525]).
في الماضي كان يتقدّم موكبَ الضاربين الطبلُ والدَّمّام، وفي الثلاثينيات من القرن الماضي وقبلها كانت تُنصب الخيام البيض للحسين وأهله وصحبه في طرف من الميدان، حيث تُقام عاشوراء في النبطيّة، وتُنصب الخيم الحمر للأمويّين، وعسكرهم في الطرف الآخر، وعند مصرع الحسين يهجم عسكر الأمويّين على خيم الحسين، ويحرقونها ويسبُون النساء والأطفال، وفي طليعتهم السيدة زينب اُخت الإمام الحسين، التي فقدت في المعركة أولادها الأربعة، والفتى المريض الإمام علي ابن الحسين الملقّب بزين العابدين.
يقول بعض المؤرّخين بأنّ شعائر عاشوراء التي تُقام في النبطيّة إنّما نشأت في إيران في القرن السابع عشر، وأنّ مسرح التعزية الذي يُقام في النبطيّة هو مسرح جاء من إيران عن طريق عدد من الإيرانيّين الذين كانوا يقطنون النبطيّة في أوائل القرن العشرين، وهؤلاء وضعوا أسس المسرح الدينيّ في لبنان([526]).
استقطبت تمثيلية استشهاد الحسين في النبطيّة كلّ الانتباه، وهناك ما يقرب من أربعين شخصاً يمثّلون فيها. كانت تمثيليّة عاشوراء تقتصر في البداية على بعض شبّان بلدة النبطيّة، فريق منهم يمثّل قوم الحسين، وفريق آخر يمثّل قوم الشمر وعمر بن سعد. كانت التمثيليّة أشبه ما تكون بالتمثيليّات الصامتة، يُقتصر فيها على أقوال معظمها باللغة
العاميّة، أو بلغة عربيّة مشوّهة. لكنّ وصول الشيخ عبد الحسين صادق([527]) إلى النبطيّة قد غيّر التمثيل، وبإشارة من إبراهيم ميرزا والد الطبيب بهجت ميرزا الذي قدم من إيران إلى النبطيّة في العشرينات من القرن الماضي، تمّ جمع نفرا من الحسينيّين (أنصار الحسین) وأوكل دورَ الإمام الحسين في المسرحيّة إلى عبد الله كحيل، ووضع كُتيِّباً لها نُقِّحت بموجبه الأدوار، وصار المشاهد يعرف من هو الإمام الحسين، ومن هم أعداؤه([528]).
وكانت المسرحيّة تُقام في الهواء الطلق. وعندما توفّي عبد الله كحيل الذي كان يقوم بدور الإمام الحسين، تولّى هذا الدور ابنه حسن كحيل، وحينما توفّي الشيخ عبد الحسين صادق تولّى بعده الشيخ محمّد تقي صادق، ومن بعده الشيخ جعفر صادق، واليوم يتولّى مهامَّ المشيخة حفيد حفيده الشيخ عبد الحسين صادق.
في سنة 1960 وُضع النصّ الكامل والصحيح لتمثيليّة عاشوراء المستقاة من كتب التاريخ الناقلة لواقعة الطف. وفي مطلع سنة 1970 أُعلن ذكرى العاشر من المحرم (عاشوراء) عطلة رسميّة في لبنان، فتزايد عدد المشاهدين والزوّار وتعاظم، ممّا اضطر القائمين على التمثيليّة إلى إنشاء مسرح في الطرف الشرقيّ من موقع التمثيل الذي أصبح معروفاً بوقف الإمام الحسين بن عليّ. والمسرحيّة اليوم تُمثّل على المسرح، ويؤدّي الأدوار ممثّلون معروفون، بعضهم من مدينة النبطيّة نفسها، وبعضهم الآخر من غيرها، ومن غير المسلمين.
إنَّ أحد مقوِّمات المسرح ولا سيّما مسرح التعزية هو الشعر، فالشعر وسيلة تعبير ولا يمكن لمسرحيّة أن تكون ناجحة إذا ما خلت من الشعر. فالنصّ الذي كُتب به مسرح عاشوراء في النبطيّة هو النثر، وقد نُقل هذا النصُّ من كتاب مقتل الحسين للخوارزميّ، ولكنَّ المقتل تضمّن أشعاراً للحسين وأبنائه وأصحابه، لا سيما عندما كانوا يبرزون إلى المعركة، وقد حفظت لنا كتب الأدب أشعاراً للحسين، ومنها:
|
فإن تكن الدنيا تُعدُّ نفيسة فإنَّ ثوابَ الله أعلى وأنبلُ |
يشاهد مسرح عاشوراء في النبطيّة عدد كبير من المواطنين، ففي سنة 1973م بلغ عدد المشاهدين ستين ألفاً. وكان عددهم في سنة 1974م ما يقارب الثمانين ألف مشاهد([530]).في القديم كان الناس يأتون إلى النبطيّة عشيّة العاشر من محرّم قادمين على ظهر فرس، أو جواد، أو على ظهر حمار، أو بغل، أو مشيا على الأقدام، وحاليّاً الجمهور هو نفسه حيث يشكّل سكان النبطيّة نفسها ربعه، والثلاثة أرباع الأخرى يشكّلها سكان القرى المجاورة ومن بيروت([531]). جمهور مسرح النبطيّة جمهور تقليديّ يأتي إلى النبطيّة بدافع التقاليد، وكثير من المشاهدين يعرف مقاطع كبيرة من التمثيليّة.
النصُّ
لغة التمثيليّة هي الفصحى، وقد اقتُبس النصّ سابقاً من كتاب للسيد محسن الأمين، ولكنَّ النص الحاليّ مقتبس من مقتل الحسين للخوارزميّ.
إنّ مسرح التعزية في النبطيّة هو مسرح شعبيّ، والشخصان اللذان يسترعيان انتباه هؤلاء هما الحسين وشمر.
قصّة مسرحيّة استشهاد الإمام الحسين×
تتضمّن مسرحيّة استشهاد الإمام الحسين ثلاثة فصول وخاتمة: يبدأ الفصل الأوّل عندما يُخبر الحسين بن علي وهو في المدينة نفرٌ من الأسديّين (بني أسد) عن مقتل رسوله مسلم بن عقيل وهاني بن عروة في الكوفة، وجرّهما في أسواق الكوفة ويناشدانه بأن ينصرف عن الذهاب إلى العراق؛ لأنّه لم يبقَ له هناك أنصار ولا شيعة. هنا يسأل الحسين بني عقيل عن رأيهم، فيقولون له إنّهم لن يرجعوا حتى يأخذوا ثأره من الطغاة. وهنا يتابع الحسين سيره إلى الكوفة، فيعترضه الفرزدق ويقول له: «سيدي، كيف تركن إلى أهل الكوفة وهم الذين قلبوا ظهر المِجَنّ لأبيك وأخيك وقتلوا ابن عمّك مسلماً وشيعته؟» ولكنّ الحسين يتابع سيره، فيعترضه الحرّ ابن يزيد الرياحي ويسأله: «سيدي ما الذي جاء بك وما أخرجك من بلد جدك؟» يردّ عليه الحسين بالقول: «لقد جاءتني كتبكم وقدِمت عليّ رسلكم، أن أقدِم علينا، وليس علينا إمام سواك، وها أنا قد جئتكم، فأعطوني من عهودكم ومواثيقكم ما أطمئنّ إليه، أمّا إذا كنتم لقدومي كارهين انصرفت من حيث أتيت».
فيردّ الحرّ: «أنا والله ما أدري ما هذه الكتب والرسل التي أنت تذكر، ولكن نحن أُمرنا إذا لقيناك لا نفارقك حتى ندخلك الكوفة إلى الأمير عبيد الله بن زياد».
ولكن الحسين يقسم له أنّه لن يتبعه إلى الكوفة، والحرّ يردّ بأنّه لن يدعه يذهب، ويخاطب الحر نفسه ويقول: «هذا ابن بنت رسول الله، أقسَمَ أن لا يتبعني، فما أنا صانع؟ هذا ريحانة النبي، هذا شبل عليّ، هذا سيّد شباب أهل الجنة». يخاطب الحرّ الحسين بقوله: «سيدي خذ طريقاً لا يدخلك الكوفة ولا يردّك المدينة يكن بيني وبينك نصفاً، وإنّي لأذكّرك الله في نفسك وآل بيتك إلّا انصرفت».
وهنا يخاطب الحسين أصحابه ويقول: «أمّا بعد، فإنّه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون ألا إنّ هذِهِ الدُّنْيا قَد تَغَيَّرَت وَتَنَكَّرَتْ وأدْبَرَ مَعرُوفُها، فَلَمْ يَبْقَ مِنْها إلاَّ صُبابَةٌ كَصُبابَةِ الإناءِ، وَخَسِيسُ عَيْشٍ كَالمَرعَى الوَبِيلِ، ألا تَرَوْنَ أنَّ الحَقَّ لا يُعْمَلُ بِه، وَأنَّ الباطِلَ لا يُتناهى عَنهَ.؟ لِيَرْغَبْ المُؤْمِنُ في لِقاءِ اللهِ مُحِقّاً؛ فَإنِّي لا أرَى الْموتَ إلاّ سَعادَةً، وَلاَ الحَياةَ مَعَ الظَّالِمينَ إلاّ بَرَماً».
|
سأمضى وما بالموت عارٌ على الفتى إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلما |
يصل ركب الحسين إلى كربلاء، يسأل الحسين أصحابه: «ما اسم هذه الارض؟» يقولون: «كربلاء»، يقول الحسين: «اللهم إنّي أعوذ بك من الكرب والبلاء! انزلوا ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا تُسفك دماؤنا، ها هنا والله تُهتك حريمنا، ها هنا والله تُقتل رجالنا، ها هنا والله تُذبح أطفالنا، ها هنا والله تُزار قبورنا، وبهذه التربة وعدني جدّي رسول الله ولا خُلف لقوله».
ثم يتوجّه بطرفه نحو السماء ويقول: «اللهم إنّا عترة نبيك محمد، وقد أُزعجنا وأُخرجنا من بلد جدّنا، وتعدّت بنو أميّة علينا. اللّهم فخذ لنا حقّنا، وانصرنا على القوم الظالمين».
وفي الفصل الثاني يرسل القائد الحرّ بن يزيد الرياحي رسالة إلى عبيد الله بن زياد والي الكوفة يقول له فيها: «أمّا بعد، فهذا الحسين ابن فاطمة قد نزل بكربلاء بجملة من أهل بيته ونفر من أصحابه، وهو يأبى كلّ الإباء الاستسلام. إنّ نفس أبيه بين جنبيه. فما أنت صانع؟».
يكتب عبيد الله بن زياد رسالة إلى الحسين يقول فيها: «أما بعد، يا حسين، فقد بلغني نزولك بكربلاء وقد كتب إليّ أمير المؤمنين يزيد أن لا أشبع من الخمير، ولا أتوسّد الوثير أو الحقك باللطيف الخبير، أو تنزل على حكمي وحكم أمير المؤمنين يزيد والسلام».
وعندما وصل كتاب يزيد إلى الحسين أخذ الحسين الكتاب وقرأه ثمّ رماه إلى الأرض غاضباً وقال: «لا أفلح قومٌ اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق». وعندما رجع الرسول إلى عبيد الله بن زياد ونقل له ردّ الحسين، طلب عبيدُ الله عمرَ ابن سعد وقال له: «هذا الحسين بن فاطمة نزل كربلاء، بجملة من أهل بيته ونفر من أصحابه، فاذهب إليه واعرض عليه النزول على حكمي وحكم أمير المؤمنين (يزيد)، وإن أبى فناجزه القتال». ووعده عبيد الله بمُلك الريّ مقابل قتال الحسين. وبعد تردُّدٍ قبِلَ عمر بن سعد المهمّة. وأمر عبيد الله عمر بن سعد بأن يسير في أربعة آلاف فارس، قائلاً له «أنت أمير العسكر والقائد الأكبر».
يتوجّه عمر بن سعد إلى كربلاء ويرسل رسولاً إلى الحسين ليسأله: «ماالذي جاء بك؟». يردّ الحسين عليه بالقول: «دعاني أهل مصركم هذا أن أقدِم، فإنّه ليس علينا إمام وإن كنتم لقدومي كارهين انصرفت من حيث أتيت».
يكتب عمر بن سعد كتاباً لعبيد الله بن زياد يخبره فيه أنّ الحسين أعطاه عهداً على أن يرجع إلى المكان الذي أتى منه، وأن يسير إلى ثغر من الثغور، فيكون رجلاً من المسلمين، له ما لهم، وعليه ما عليهم.
ولكنّ الشمر يوسوس لعبيد الله بن زياد ويقول له: «والله لإن رحل الرجل (الحسين) من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكوننّ أولى بالقوة، ولتكوننّ أولى بالضعف. فلا تعطِه هذه المنزلة، ولينزلْ على حكمك هو وأصحابه، فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة، وإن عفوت كان ذلك لك.
رأى ابن زياد أنّ رأي الشمر كان مصيباً. فكتب كتاباً إلى عمر بن سعد يوبّخه ويقول له: إني لم أبعثك إلى الحسين لتطاوله ولا لتعتذر منه، ولا لتكون له عندي شافعاً، ولا لتمنّيه السلام والبقاء. فاخرجْ إليه واعرض عليه النزول على حكمي وحكم أمير المؤمنين يزيد، فإن أبى فازحف عليهم حتى تقتلهم، وتُمثّل بهم، فإنّهم لذلك مستحقّون، وإن أنت قتلت حسيناً فأوطئ الخيل صدره وظهره، وإن أنت خضعت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أنت أبيت فاعتزل عملنا وخلّ بين شمر والعسكر، فإنّا قد أمرناه بأمرنا.
يعطي ابن زياد الكتاب إلى شمر، ويطلب منه أن يأخذه إلى ابن سعد. يصل الشمر إلى كربلاء ويسلّم كتاب عبيد الله إلى عمر بن سعد، يأخذ عمر بن سعد الكتاب من الشمر ويقرأه ويقول للشمر: ما لك؟ لا قرّب الله دارك؟ وقبّح ما قدمت علينا، لقد أفسدت علينا ما رجونا أن يصلح، لا يستسلم والله حسين. إنّ نفس أبيه بين جنبيه».
يسأل الشمر عمر ابن سعد عن خططه في مواجهة الحسين يردّ عمر عليه بالقول: «ما هي إلّا أن نميلَ عليهم بأسيافنا ميلة واحدة، فنفنيهم عن آخرهم». ولكنّ الشمر يقترح عليه أن يذهب إلى معسكر الحسين، ويعطي الأمان لأصحاب الحسين لعلّهم يتركونه. يوافق عمر بن سعد على فكرة الشمر. يتوجّه الشمر ناحية مخيّم الحسين وينادي: «أين بنو أختنا؟ أين العبّاس وأخوته؟»(ثلاث مرات). وعندما لايردّون عليه يعطي الشمر الأمان للعبّاس وإخوته. ولكن العبّاس يردّ عليه ويلعنه ويقول له: «أتؤمننا وابن بنت رسول الله لا أمان له؟ تبّت يداك وبئس ما جئتنا به من أمان يا عدو الله».
يرجع الشمر إلى معسكره، فيصيح ابن سعد بالجند: يا خيل الله اركبي، تركب العساكر وتتّجه ناحية مخيّمات الحسين. يطلب الحسين من أخيه العبّاس أن يذهب إلى العساكر، وأن يسألهم ما الذي جاء بهم وماذا يريدون؟ يردّ أحدهم بالقول: «لقد جاءنا أمر الأمير أن نعرض عليكم التسليم أو نناجزكم القتال هذه الليلة».
يذهب العبّاس إلى أخيه ويقول له بأنّ القوم يعرضون علينا التسليم أو القتال. يطلب الحسين من أخيه العبّاس أن يرجع إليهم لعلّه يستطيع تأخيرهم إلى غداة غد كي يصلي العشية. يذهب العبّاس إلى القوم ويطلب منهم تأخير القتال، لكنّ أحدهم يقول لا بدّ من مناجزتكم القتال هذه الليلة، ولكنَّ عمر بن الحجاج يقول للقوم: «والله لو أنّهم من الترك والديلم وسألونا مثل ذلك لأجبناهم، وكيف وهم آل محمد!؟». وعندها يُجاب طلب العبّاس.
الفصل الثالث، عندما يطمئن الحسين أنّ القوم عازمون على قتله، يطلب من أصحابه التفرّق والنجاة من القتال. ولكنّ أصحابه وعلى رأسهم حبيب بن مظاهر يأتون إلى الحسين ويقولون له: «هذه صوارم فتيانكم آلوا أن لا يغمدوها إلّا في رقاب أعدائكم، وهذه أسنة غلمانكم آلوا أن لا يركزوها إلّا في صدور من يبتغي السوء بكم».
يردّ الحسين على أصحابه بالقول: «جزاكم الله عن آل بيته وأصحابه»، شاخصاً بطرفه نحو السماء قائلاً: «اللهم إنّي أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوّة، وعلَّمتنا القرآن وفقّهتنا في الدين، وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة، فاجعلنا من الشاكرين».
ويتوجّه الحسين إلى معسكر الأعداء يخاطبهم وبعد أن يعرّف نفسه يقول لهم: «فانسِبُوني وانظُروا مَنْ أنَا، ثمَّ ارجِعُوا إلى أنفسِكُم فعاتِبُوها، وانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟» ثم يشير الحسين إلى: «أنّ أهل الكوفة دعوه ثمّ نكثوا عهدهم، ألا إنّ الدعيَّ بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلة! يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون». ثمّ يرفع يده إلى السماء ويقول: «اللهمَّ احبس عنهم قطر السماء، وأبعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبَّرة، فإنّهم كذّبونا وخذلونا، وأنت ربّنا عليك توكّلنا واليك المصير».
وهنا، نرى الحرّ بن يزيد الرياحيّ الذي قطع الطريق على الحسين، وقد هاله موقف الأمويّين من الحسين وأصحابه، فيذهب إلى ابن سعد ويسأله هل سيقاتل الحسين ويسمع منه قوله: «أي والله قتال أيسره أن تطير الرؤوس وتطيح الأيدي». عندها يتخذ قراره بالذهاب إلى الحسين والاعتذار منه، والقتال بين يديه. ويهمّ التوجه إلى الحسين محدّثاً نفسه: «والله إنّي لأخيّر نفسي بين الجنة والنار، اللهمّ إني أتوب فتب عليّ. فقد أرعبتُ قلوبَ أولاد بنت نبيكَ».
يقف الحرّ أمام الحسين يسلِّم عليه، يعرّفه بنفسه ويقول: «أنا صاحبك الذي حبسك عن الرجوع، وما علمت أنّ القوم يرفضون ما عرضته، ولو علمت ما ارتكبت. أهل ترى لي بعد هذا من توبة؟».
الحسين: «إن تبت يتوب الله عليك». يتوجه الحرّ نحوَ أهل الكوفة. فيلومهم على دعوتهم الإمام الحسين، وعدم نصرته ومحاربته، ويخرج للبراز والقتال فيُقتَل في المعركة ويؤبّنه الحسين ويقول: «ما أخطأتْ أمُّك إذ سمتك حراً، أنت حرٌ في الدنيا والآخرة». بعد ذلك يخرج أصحابه وأهل بيته الواحد تلو الآخر فيقتلوا في ساحة القتال. يتقدّم الحسين إلى أهل الكوفة فيخاطبهم ويقول: «يا أهل الكوفة، إذا كنتم لا تراعون قرابتي من رسول الله، فارجعوا إلى جاهليّتكم، فابرزوا فارساً لفارس، اثنان لفارس، خمسة لفارس، عشرة لفارس».
فيبرزون له فيقتل منهم خلقاً كثيراً، عندها يصيح عمر بن سعد بأهل الكوفة: «يا أهل الكوفة: أتدرون من تبارزون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتّال العرب، والله لو بارزتموه واحداً واحداً لأفناكم عن آخركم! فاحملوا عليه فِرقاً: فرقة بالرماح وفرقة بالحجارة وفرقة بالسيوف وفرقة بالنبال».عندها يحملون عليه جميعهم فيُثخَن بالجراح ويسقط على الأرض، فيتحلّقون حوله یرهقونه حتى يقضي شهيد الحق والواجب.
في تلك اللحظة تُقام التكبيرات إعلاناً باستشهاد الحسين، ویُسدَل الستار على فصول المسرحيّة.
مسرح عاشوراء في النبطيّة، ومحاولات تطويره
جرت محاولات جدّيّة لتطوير مسرح عاشوراء الذي يجري في النبطيّة وإعطائه وجهاً فنيَّاً حديثاً ملائماً لبيئة لبنان، يخرجه من مناطقيّته، فقد كلّف الشيخ عبد الحسين صادق المشرف على احتفالات عاشوراء في النبطيّة المخرج اللبنانيّ رئيف كرم لإعداد المقتل للمسرح وإخراجه([532]).
اتخذ المخرج المسرحيّ اللبنانيّ رئيف كرم من واقعة مقتل الإمام الحسين منطلقاً لتحويلها إلى مسرحيّة تأخذ طابعاً احترافيّاً لأوّل مرّة، وتُعرَض في جنوب لبنان في يوم العاشر من محرم. وعاشوراء مسرحيّاً هي أوّل عمل يعود به كرم إلى الخشبة. وكان طموح كبير يغمر نفس كرم بأن يجعل هذا العمل يضاهي الأعمال التي تُقدّم على المسارح العربيّة العالميّة.
وفي هذا الإطار ِاستقدم المخرج رئيف كرم من هولندا الموسيقارَ المعروف نجيب شيرادي في فرقة وشم، وتعاون معه للشريط الصوتي الخاص في هذه المناسبة. وأوضح كرم أنَّ هذا نوع من المسرح يتواجد لدى كلّ شعوب العالم، أمّا في الإسلام، فإنّه غائب إذ لا مسرح عند المسلمين في المجتمعات القديمة إلّا خيال الظل الذي اندثر، ولم يعد له استمرّاريّة حتى اليوم. وهكذا أخذ كرم على عاتقه مهمّة تحويل العرض التقليديّ الذي كان يُقدَّم في النبطيّة إلى مسرحيّة ميلودراميّة واقعيّة حديثة تحتوي على الطقس الذي يعبّر عنه كرم بالصوت المغنّى، أو الندبيّات أو الإيقاعات كحركة اللطم([533]).
وأشار كرم إلى أنَّ حركة اللطم يشتغل فيها كلّ الجسد، وتصدر عنها أصوات ذات إيقاعات منتظمة. هذا فنّ نادر نبحث عنه. بالإضافة إلى اللطم فإنّ عشق البكاء يجمع الناس في عاشوراء، ولهذا قال كرم: إنّ هذا البكاء سنحافظ عليه في العرض، ولكنْ إذا طوّرنا عاشوراء وأعطيناها التلوين أو التقاسيم التي هي أساس الفنّ الإسلاميّ، وحوّلنا عناصرها الحركيّة المستقاة من الطقوس والأصوات المستوحاة من الندبيّات، وحدثّناها فإنّها ستُصبح عملاً فنيّاً رائعاً، مثل أهمِّ الأعمال الفنيّة الموجودة في العالم، والتي لها علاقة بتراث الشعوب مثل أوبرا عايدة الكلاسيكيّة. وأضاف: حينئذ يمكننا أن نوصلها إلى مستوى راقٍ من الجماليّة الفنيّة، على الرغم من أنّ العرض يُقدّم في النهار، أمّا اذا استطعنا تقديمه في الليل أمام هذا الجمهور الحاضر، والذي يُقدَّر بعشرات الآلاف في هذا الملعب الذي تُقدّر مساحته بعشرة آلاف متر مربع، وأُضيف إليه عنصر الإضاءة والسينما والجرافيك والليزر فهناك الأفق الفنيّ الأهم. واستعان كرم في عمله بدمى عملاقة و200 لاعب وممثّلين محترفين، يجسّدون أدوار الإمام الحسين وأهل بيته وصحبه في تلك الملحمة التاريخيّة التي تتحوّل لأوّل مرّة إلى عمل فني احترافي([534]).
«ومن ناحية السينوجرافيا عمل مع كرم فريق بإشراف الفنان محمّد شمس الدين الذي يركّز على إظهار المواكب، وأبرزها موكب يزيد بكلّ ما يعني من شخصيّة لديها فرادة كما يقول كرم. وتحدّث عن العنف في عاشوراء الذي رأى أنّه قد يصل إلى مستوى التراجيديات العالميّة الموجودة في تراث الشعوب من اليونان إلى الهند.. الإمام يقول حرفيّاً»اللهم اجعل من خسارتنا في العاجل نصراً لنا في الآجل«.. أي إنّه جاء ليموت من أجل مبادئه، فهو يُعدّ الدولة الأمويّة متجبّرة ومتسلّطة على الناس، حوّلتهم إلى فقراء. وجاء الإمام ليواجه الحكم الظالم ويحافظ على عدالة الدولة الإسلاميّة القديمة، مثلما وقف المسيح في وجه حاخامات اليهود، وقال لهم: أنا ضدّ شرائعكم التي تفرضونها على الناس». يؤكّد كرم أنّ هذا العرض قد يؤشّر إلى ولادة مسرح جدّي في لبنان، ويقول: إنَّ ولادة المسرح العربيّ بدأتْ مع النّقاش في بيروت، وانتقلتْ إلى مصر. أمّا عاشوراء وعلى الرغم من أنّ النصَّ الموجود يغلب عليه الطابع الأدبيّ الخطابيّ، ولكنَّ العرض يحتوي على مقوّمات أخرى انطلقتُ منها لأقول إنَّ عاشوراء كان يمكن أن تكون نقطة الانطلاق للمسرح اللبنانيّ، وتالياً العربيّ والإسلاميّ. فالمسرح الوحيد الذي يمكن أن نسمّيه إسلاميّاً في تاريخ الإسلام هو عرض عاشوراء([535]).
يبدو أنّ النتيجة لم تكن مرضية للمؤسّسة الدينيّة التي كلّفت رئيف كرم بالعمل، لذلك أُهمل المشروع لاحقاً([536]). وحقيقة الأمر أنّ مسرحيّة عاشوراء يمثّلها على المسرح نهاراً نخبة من الفنانين اللبنانيّين، بناءً على نصٍّ مكتوب لدينا نسخ عنه تعود لأحد الممثّلين وهو حسام الصباح.
3 ـ مسرحيّة «الحسين ثائراً والحسين شهيداً» لعبد الرحمن الشرقاوي([537])
أنهى الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي كتابة مسرحيّة (الحسين ثائراً والحسين شهيداً)، في شباط/فبراير 1969 في القاهرة، وقُدِّمت المسرحيّة بعنوان (ثأر الله) على خشبة المسرح القوميّ بالقاهرة في العام 1971م، ثمّ توقَّف العمل بعد 42 ليلة من البروفات، وتمّ تأجيله إلى أجل غير مسمّى. قُدّم نصُّ المسرحيّة في العام 1971 لمشيخة الأزهر ووافقت عليه، بشرط إجراء تعديلات منها أن يصعد الممثّل الذي يجسّد (الحسين) ليقف على خشبة المسرح ويقول: «أنا لست حسيناً، ولكنِّي أروي عنه». بالإضافة إلى أنَّ الممثّل نفسه سيظلُّ حتى منتصف العرض تقريبا يقول: قال الحسين «ليستوعب الجمهور أنَّه ينقل عن الحسين ولا يجسّده، والشيء نفسه مع الممثّلة التي تنقل عن السيدة زينب».
يقول أحمد عبد الرحمن الشرقاوي ابن الكاتب «إنّ الجماعات الدينيّة المتزمّتة هي التي منعت عرض مسرحيّة الحسين ثائراً وشهيداً وليس الأزهر»([538]).
المسرحيّة تتكون من قسمين القسم الأوّل: (الحسين ثائراً) ويتناول خروج الحسين من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، وإستقراره في كربلاء، ومواجهته جيش يزيد. والقسم الثاني: (الحسين شهيداً) يتناول المعركة بين الحسين وأصحابه وجيش يزيد، واستشهاد الحسين في كربلاء، وأخذ نسائه وأطفاله أسرى إلى الشام، وانتقام المختار بن عبيدة الثقفيّ من قادة جيش يزيد، وقتلهم جميعاً.
تتميّز مسرحيّة عبد الرحمن الشرقاوي (الحسين ثائراً والحسين شهيداً) عن (مجلس تعزية استشهاد الحسين) بالفارسيّة، ومسرحيّة (استشهاد الإمام الحسين) التي تُمثَّل في النبطيّة بلبنان، بأنّها أكثر تركيزاً على دور الإمام الحسين وأهدافه، التي ثار من أجلها ضدّ يزيد، وبيان أهداف الثورة التي كانت تقوم على إحقاق الحقّ، والمطالبة بالإصلاح، وإقامة العدل بين الناس، والإطاحة بحكّام السوء؛ لانفرادهم بالحكم، وجعل الحكم وراثة، وعدم الاعتراف بحكم يزيد الذي ورث الحكم عن أبيه.
سعيد بن سعيد: من أصحاب الحسين، بشر: من فتيان الحسين، أسد: شيخ حجازيّ يعيش في الكوفة، وحشي: قاتل حمزة عم النبي، الوليد: أمير المدينة، مروان ابن الحكم: صاحب بيت المال بالمدينة، الحسين بن علي، محمّد بن الحنفيّة: أخو الحسين، زينب بنت علي: شقيقة الحسين، سكينة بنت الحسين، علي بن الحسين، زيد ابن الأرقم، هاني بن عروة، برير: شيخ عراقيّ، ابن زياد أمير الكوفة، شمر بن ذي الجوشن: من أتباع ابن زياد، الحرّ الرياحي قائد عراقيّ، المختار الثقفيّ.
تناول الكاتب في بداية المسرحيّة حكومة معاوية بن أبي سفيان على شكل حوار بين أنصار معاوية والحسين، واصفاً حكومة معاوية بأنّها دولة الظلم الوبيل؛ إذ أخذ معاوية قبل موته البيعة لابنه يزيد قهراً، واصفاً يزيد بأنّه السكِّير الذي يعبث بالقرد نهاراً، ويتناول الخمر ليلاً، ويصلّي تحت أرداف الجواري.
وفي هذه المسرحيّة يُجري الكاتب حواراً بين أنصار الحسين وأنصار يزيد بن معاوية، حيث يدعو أحد أنصار يزيد الحسينَ إلى مبايعة يزيد، وحقن دماء المسلمين، بينما يرى أنصار الحسين بأنّه إذا ما أصبح الحسين إماماً للمسلمين سيقيم العدل في الناس، وسيغلو في محاسبة الأثرياء الكانزين، كما فعل أبوه عليّ عندما حاسب أنصار معاوية على ما اقتنوا، وعندما ردَّ إلى بيت المال ما كنزوا، وعندما نازعهم في إقطاعهم وسوّى بين المسلمين.
وهنا يشير الكاتب إلى أسلوب معاوية ويزيد في تقديم الرشاوى والأعطيات لكسب الأصحاب والأنصار، مقابل البيعة لهما، ومنها آلاف الدنانير والضِّيَع والدُّور، والجواري من بنات الروم، وشراء الضمائر بالدينار والذهب.
وينتقل الكاتب إلى الحديث عن معاوية وأمّه هند بنت عتبة، وكيف أنَّ هنداً كلفت رجلاً اسمه (وحشي) بقتل حمزة سيد الشهداء عمّ النبي، في معركة أُحد التي وقعت في الخامس عشر من شوّال سنة 3 للهجرة، وبعد أن قام وحشي بقتل حمزة، بقرت هند بطن حمزة وأخرجت كبده فلاكته، فلم تستطع أن تسيغه، فلفظته، ويشير الكاتب إلى أنَّ معاوية حكم المسلمين بحدّ السيف، وأنَّ ابنه يزيد إنْ ولي الأمر سوف يرمي المسلمين بعسكر الشام الشداد.
وفي المشهد الأوّل من مسرحيّة الحسين ثائراً يُجمع أنصار الحسين على وجوب أخذ البيعة للحسين بن علي؛ لأنّه لا بيعة في ظلّ القهر، ولا بيعة إلّا للحسين، و«لن يحكمنا جبّار ضرباً بالسيف البتّار، حيّ على ثأر الله، لا بيعة إلّا للحسين».
وفي المشهد الثاني يذهب الحسين إلى قصر الوليد بن عتبة والي المدينة بعد أن استدعاه؛ ليقول له بأنّ معاوية قد مات، وأنّ عليه أن يبايع يزيد، ولكنّ الحسين يقول للوليد أنّه لا يعقد البيعة سرّاً، ويقول إنَّ موعدنا ظهر غد بعد الصلاة، ولكنَّ الوليد يقول للحسين: «نحن لا نطلب إلّا كلمة فلتقل: بايعت، واذهب بسلام لجموع الفقراء، فلتقلْها وانصرف يا ابن رسول الله حقْناً للدماء، أنا ناصح لك، بايع يزيد واسترح!».
ولكن الحسين يردّ على الوليد بقوله: «لا لن أجامل في مصير المسلمين، ولن أهادن أو أصانع. وعندما واجه الحسين تهديد مروان بن الحكم الذي يقول: (تخيّر لنفسك إحدى اثنتين: فإن لم تبايع بعثنا برأسك)، يخرج الحسين من القصر يحيط به فتيان بني هاشم.
وفي المشهد الثالث، يحمل الحسين تحت الظلام جوالات يضع بعضها على أبواب البيوت، من دون أن يعرف أحد، ثم يمضي مع أصحابه ليصلّيَ الفجر، ويجري حوار بينه وبين أحد مؤيدي يزيد بن معاوية الذي ما فتئ يدعو الحسين إلى مبايعة يزيد من أجل حقن الدماء، ولكنَّ الحسين يردّ على هذا بالقول: (قسَماً بالله ما أُنشد فتنة، أنا لا أُنشد ملكاً بينكم، فأنا أزهد أهل الأرض في هذا ـ وإن كان لي الحقّ عليكم ـ إنّما أنشد أن أرفع جوْر الحاكم الظالم عنكم، أنا لا أبغي سوى الإصلاح فيما بينكم، فإذا وُفّقت أعذرت، وإن أفشل عُذرت.. وإذا هم قتلوني دون ما أنشد من خير لكم، فلقد وفّيت لله ديوني وقضيت).
وهنا يعلن الحسين لأصحابه:
(لا بل عزمت على الرحيل فلا لجاج ولا خصام). (أنا ذا أهاجر في سبيل الله للبيت الحرام)، (أنا لا أخاف على نفسي، وما أفرُّ من المخاوف)، إنِّي أخاف على الحقيقة والعدالة والسلام».
ويقف الحسين أمام قبر الرسول| بعد صلاة الفجر ويناجي جدّه محمّداً ويقول:
«يا رسول الله قد جئت إليك / الحسين بن علي وابن بنتك، هو ذا قد لاذَ بك / يرتجي رحمة ربك / فأعِنه يا رسول الله.. فالليل ثقيل !. بأبي أنت وأمي يا رسول الله إذ أُبعد عنك / وأنا قرة عينك / إنّني أرحل عن أزكى بلاد الله عندي خراجاً، بالرغم مني.. غير أنّي.. أنا لا أعرف ما أصنع في أمري هذا فأعنِّي / أنا إن بايعت للفاجر كي تسلم رأسي، أو لكي يسلم غيري.. لكفرت / ولخالفتك فيما جئتَ للناس به من عند ربك / وإذا لم أعطه البيعة عن كرهٍ قُتلت !/ وإذا عشت هنا كي أحشِّد الناس عليه / خاض من حولك بحر من دماء الأبرياء !../ موقف ما امتُحن المؤمن من قبلُ به، أو سِيق إنسان إليه..!/ امتحان كامتحان الأنبياء !/ أترى أمنحه بيعة ذلٍّ؟ / بعدها آمن في بيتي وأهلي، مثل شاة في قطيع !!، ثم أسقى الناس خمر الراحة الممزوج بالذلّة، في كأس بديع من ذهب !؟ /.
أم ترى أجهر بالثورة في وجه الطغاة؟ / لا أبالي بالذي يحدث منهم، إذ يجدّون ورائي في الطلب!؟ / مستخفّاً بالحياة، بحياتي وحياة المسلمين الآخرين..؟ / موقف ما امتُحن المؤمن من قبل به، أو سبق إنسان اليه! / امتحان كامتحان الأنبياء! /آه لو تنكشف الغمّة عن عيني كي أبصر أبعاد الطريق؟/.
ويلتقي محمّد بن الحنفية بأخيه الحسين الذي يقف إلى جانب قبر جدِّه الرسول، ويحاول أن يثنيه عن مواجهة بطش يزيد، ولكنّ الحسين يعلن لأخيه بأنّه لن يترك الظالم حتى يأخذ المظلوم حقّه، إنّه لا يريد أن ينأى بنفسه عن نصرة الحقّ، ودفع الظلم عن أمّة جدّه. ويخبره الحسين أنّه ذاهب إلى مكّة، ويضيف:
إن تضق أمُّ القرى بي.. فسأمضي هائماً بين الشعاب / داعيا لله..للحقّ.. مثيراً من هُم تحت التراب.
يناجي الحسين ربّه ويقول:
ربي.. إلى مَن تُوكِل العبد الضعيف؟ / أنا ذا أدعوك مثل جدّي حين طارده رجال من ثقيف / قد أتاهم بالهداية، إنّي فزعت من دنيا يزيد /وهرعت نحو رحابك القدسيّ بالخير الطريد / وبكلّ أحلام السلام وكلّ آمال العدالة.
ويرتمي الحسينُ مُنهَكاً على قبر جده ويتمدّد وراء القبر، تقبل أختُه زينب وتقول: أرسل الوالي يطلبون الحسين، أنذروا إن لم يجئهم وحده قبل الضحى مستسلماً لأتوه ليجروه إليهم مرغماً، وتدعو الحسين إلى الرحيل؛ لأنّ الضحى يقترب، وسيقبل الجند الغلاظ ليحملوك إلى الأمير، ويردُّ الحسين عليها بالقول: سأسير من فوري لمكّة بالنساء وبالعيال.
وفي المشهد الخامس یكون الحسین في مكّة، ويأتيه ابن عمه محمّد بن جعفر الطيّار، وينقل إليه أمر يزيد بأنّ من يأتي بالحسين حيّاً أو ميتاً يولّيه ما يشاء، وله في كلّ عام ألف ألف، ويقترح ابن جعفر على الحسين أن يهادن يزيد، ريثما يهدأ، ويقول: أنا أدعوك إلى شيء من الحكمة والريث؛ لتدبير الأمور، ولكنّ الحسين يقول له: فإذا لم أهادنه.. وهاجرت بفتياني وأهلي؟ يرد عليه ابن جعفر: أُرسِلَ الأجناد من خلفك لا يلوون حتى يرجعوك. ويسأل الحسين: فإذا ما لذتُ بالكعبة كي آمن في جار الحرم؟ يقول ابن جعفر: هدم الكعبة فوقك.
وهنا يقول الحسين:
آه ما أهون دنياكم على طفل الحقيقة! /هكذا أصبح الخير طريداً يتوارى في الخرق!/ وغدا الحقّ شريداً، يدريه البغي من أفق لأفق!/ والدنايا تزدهي بالطيلسان/ فإذا الباطل فوق العرش وحده /في يديه الصولجان / ملكه الزيف وأسراه الدموع / تنحني من دونه كلُّ الفضائل / يلتمس لديه البركات! ».
وفي المشهد السادس يجري حوار بين المختار ابن عبيدة الثقفي أحد أصحاب الحسين ومبعوث الحسين مسلم بن عقيل في الكوفة؛ لشراء السلاح والانقضاض على عبيد الله ابن زياد والي يزيد في الكوفة.
وفي المشهد السابع يصل مبعوث مسلم بن عقيل من الكوفة يحمل خرجين فيهما رسائل أهل الكوفة، يطلبون من الحسين القدوم إليهم، ومن بين الرسائل رسالة مسلم بن عقيل الذي كتب للحسين:
«يا إمامي طاب والله الجناب /إنّ في الكوفة آلافاً من الأُسد الغضاب / زأرت تحت عرين الحقّ ما ينقصها إلّا الإمام / إنّني خلفت آلاف البواتر / كلُّها تمضي بأمر ابن علي عندما يأمر لا تسأله فيما أمر.».
وبعد أن يقرأ الحسين كتب أهل الكوفة يقول:
«أنا ماض للعراق / سأطوف بالكعبة سبعاً ثم أمضي للعراق».
ويتوجه لزينب بالقول:
«استعدِّي يا أخيَّه أنا ماض برجالي ونسائي وعيالي أجمعين».
ولكنَّ ابنَ جعفر يُثني الحسين من الذهاب إلى العراق، ويقترح عليه البقاء في المدينة، علّه يأخذ عهداً من والي المدينة ليعيش الحسين في ظل السكينة، ولكن الحسين يردّ عليه بالقول:
«أأعيش طريداً حذر الموت/ أأعيش طريداً حذر السّمّ أو الخنجر/ فبما أنّ الموت قضاء وقدر/ يأتي مهما يتأخّر/ ولكيلا أسكت عن منكر/سأخرج مؤتزراً سيفي دفاعاً عن شرف الأمة.. عن شرفي. أنا ثأر الله إن متّ شهيداً/ فأطلبوا الثأر من السفّاح أيّا ما يكون».
يتوجّه الحسين إلى العراق مع أصحابه وأهل بيته، ومسلم بن عقيل شريد في طرقات الكوفة، يتحدّث مع نفسه ويقول:
«ها أنت سليب الدار/ غريب الجار/ طريد في طرقات الكوفة / لم تطعم شيئاً مذ يومين / ولم تشرب قطرة ماء ».
ويدخل بيت امرأة تأويه، وتقدّم له الماء والطعام. ويتكلّم مسلم مع نفسه ويقول:
«من مبلغ عنّي الحسين نصيحتي ألا يجيء إلى العراق / نكث الرجال بعهدهم. إنّ العهود هنا شقاق / يا نسمة الليل الثقيل المدلهم، سيري إلى ركب الحسين / سيري بدمعي فاسكبيه، وبلّغيه أنّ الذين استصرخوه وبايعوه قلبوا له ظهر المجنّ».
لكنّ جند عبيد الله بن زياد يدخلون دار المرأة، ويلقون القبض على مسلم من وشاية لابنها، ويأتون به إلى ابن زياد، وبعد حوار بين الجانبين يأمر ابن زياد بضرب عنق مسلم، وإلقاء جسده من على دار الإمارة. ويطلب مسلم من ابن زياد أن يسمح له بالصلاة، ولكن ابن زياد يدعو الحراس إلى قطع رأس مسلم.
وهنا يقول مسلم:
«لعن الله رجالا خذلونا (وهم يجرّونه) / فليطهّر دمنا الطاهر أرضَ الله من أهل الفساد / لعن الله يزيد والدعيَّ ابن زياد / بأبي أنت وأمي يا حسين عُدْ إلى جدك... لُذْ بالحرمين».
يصل الحسين وأصحابه وأهل بيته إلى شاطئ الفرات، ويدعو الحسين أصحابه إلى أخذ الماء وتعبئة القرب، وسقي الخيل والبعير.
يُخبر الحسين أصحابه وأهل بيته بمقتل هاني بن عروة ومسلم بن عقيل، والنساء يظهرنَ على باب الخيمة وينادينَ:
«وامسلماه واغربتاه..يا ويلتاه.. وا ويلتاه، واثاراه.. واثاراه... قتلوا ابن عم رسول الله».
ويخرج رجال وينسحبون بعد أن يتشاوروا بعيداً عن الحسين وأصحابه. يخرج الرجال جميعاً ووراءهم سعيد، ولا يبقى إلّا برير وبشر وثلاثة آخرون ثمّ زينب.
«زينب تتأمّل المسرح الخالي حزينة
زينب: أسفاه قد ذهب الجميع، ولم يعد إلّا القليل الصابرون./
الحسين×: (يأتي إلى الخيمة ويتأمّل المكان الذي خلا من الرجال)
أين الرجال؟ إنّي سمعت لجاجهم من خلف أستار الخيام/.
سعيد الذي خرج مع آخر مجموعة من الرجال يأتي فزعاً
سعيد: يا للحسين.
زينب: أسفاه قد هرب الرجال.
سعيد: هربوا بما أخذوه من مال وأنعام وفيرة /.
برير: أين الرجال القائمون على العهود؟ /
زينب: فسد الزمان ولم يعد إلّا الرجال الخائرون / أين الرجال الصامدون؟ ذوو الضمائر /أهل البصائر، خمص البطون من الصيام، صفر الوجوه من القيام/.
حُمر العيّون من البكاء /
زُرق الشفاه من الدعاء /
أسفاه قد ذهبوا جميعاً. /
(الحسين حزيناً ثم منفجراً)
ما عاد في هذا الزمان سوى رجال كالمسوخ الشائهات /
يمشون في حلل النعيم وتحتها نتن القبور /
يتشامخون على العباد كأنّهم ملكوا العباد /
وهمُ إذا لاقوا الأمير تضاءلوا مثل العبيد /
صاروا على أمر البلاد فأكثروا فيها الفساد/
أعلامهم رُفعت على قمم الحياة /
خِرَقٌ مرقَّعةٌ ترفرف بالقذارة في السماء الصافية/
راياتهم مُزق المحيض البالية /
يا أيّها العصر الرزي لأنت غاشية العصور /
قد آل أمر المتّقين إلى سلاطين الفجور /
قلْ أيّ أنواع الرجال جعلتهم في الواجهات؟ /
قل أيّ أعلام رُفعن على البروج الشاهقات؟
يا أيّها الشرفاء لا تهنوا إذا طغت الذئاب.. /
سيروا بنا؛ كي ننقذ الدنيا من الفوضى ومن هذا الخراب /
سيروا بنا نُعِدْ للعصر رونقه القديمَ وننصرَ الحقَّ الهضيم».
وقد أهدى الشرقاوي المسرحيّة لأمّه وقال في إهدائه:
«إلى ذكرى أمّي أهدي مسرحيّتي (الحسين ثائراً) و(الحسين شهيداً. لقد حاولت من خلالهما أن أقدّم للقارئ والمشاهد المسرحيّ فيهما أروع بطولة عرفها التاريخ الإنسانيّ / كلّه دون أن أتورّط في تسجيل التاريخ بشخوصه /وتفاصيله /التي لا أملك أن أقطع فيها بيقين. إلى ذكرى أمّي التي علّمتني منذ طفولتي أنْ أحبَّ الحسين ذلك الحب الحزين الذي يخالطه أغلب الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسىً غامضاً، وحنيناً إلى العدل والحريّة والإخاء وأحلام الإخلاص».
اقتفى عبد الرحمن الشرقاوي أثرَ أمّه منذ الطفولة، وسمع دعاءها وتوسّلها عند مسجد الحسين×، ومسجد السيدة زينب في القاهرة، فنَمَتْ مشاعره بهذا الاتجاه، وبدأ بحثاً مضنياً عندما شبّ وترعرع، وبوعيه الثقافيّ تتبّع شخصيّة الإمام الحسين×، فاستجمع تاريخه على يدي سنين حياته فعاش الحسين× في وجدانه وكيانه، وأصبح عنده رمزاً عالياً لا تماثله أيّ شخصيّة نضاليّة في العالَم.
«هذا الشاعر الكبير جاءت كتابته للمسرحيتين ممزوجة بالصدق والدموع والنضال والثورة العارمة على الطغاة، وأصبحت ملحمة من الملاحم التاريخيّة الخالدة، وعمّق خطّاً مسرحيّاً إسلاميّاً تخطّى الأطر المحليّة إلى العالميّة، لقد أثارت المسرحيتان ضجّة في الأوساط الثقافيّة عند نزولها إلى الأسواق في أواخر الستينيات، وهي من أبرز المسرحيّات الشعريّة، وأضافت قيمة كبيرة إلى المسرح الشعريّ وعمّقته، هذا المسرح الذي بدأه الشاعر أحمد شوقي ومن روّاده نعمان عاشور وصلاح عبد الصبور ومحمد عفيفي مطر والشاعر محمّد علي الخفاجي وعبد الرزاق عبد الواحد». لقد استهوت المسرحيّة بأجزائها الكثير من المخرجين بأن تُقدَّم على المسرح المصريّ، وكان أبرز هؤلاء المخرجين المخرج كرم مطاوع الذي جنّد نفسه لإخراجها مع نخبة من ألمع نجوم المسرح المصريّ آنذاك مثل عبد الله غيث وسميحة أيوب.
وتبدأ قصّة إخراج المسرحيّة من العراق، عندما جاء كرم مطاوع مع زوجته سهير المرشدي لزيارة العراق، وإلى مدينة كربلاء المقدّسة؛ لزيارة قبر الحسين×؛ ليطلع بنفسه على أرض المعركة، ورافقه جمع من الممثّلين والمخرجين والكتّاب العراقيّين أمثال يوسف العاني. روى الأستاذ عزيز عبد الصاحب (الذي كان ضمن الوفد المرافق) بعد عودته من كربلاء المقدّسة، قال: «كنا قد وصلنا إلى مدينة كربلاء المقدّسة، وفور وصولنا قمنا بزيارة ضريح الإمام الحسين×، وتفقّدنا أرض المعركة، بعد ذلك ذهبنا إلى بيت المرحوم الفنان عزي الوهّاب وكان البيت من الطراز القديم، وهيّأ لنا مكاناً في (أُرسي)([539]) البيت، كان ذلك سنة 1970م.
لقد زيّن الدار بالبسط والسجاد العربيّ، وأشار عليه الأستاذ يوسف العاني بأن يدعو لنا شخصاً يقرأ المقتل (مقتل الحسين) جيّداً، ففعل وأتى بشخص متوسّط العمر من قرّاء المقتل الجيّدين، وبعد استراحة قصيرة اعتلى الكرسي، وبدأ يقرأ المقتل بصوت حنون رقيق، ترافقه الحركات التي كان لها وقع عندنا، كما تعمّد التركيز على المقاطع الحيّة من الكلمات، وأقنعنا بأنّه من المتمرّسين بهذا الشيء، وكانت نقلاته في الحديث تتحدّد، إلى أن وصل إلى منتصف المقتل، فانتزع البكاء بسخاء، أوّل الباكين كان يوسف العاني، وتَبِعتْهُ سهير المرشدي زوجة كرم مطاوع، ثمّ كرم مطاوع والبقية الباقية، وعندما انتهى هذا الشيخ من قراءة المقتل قال له كرم مطاوع: (والله لم يُبقِ لي هذا الرجل شيئاً أخرجه)، وأخذ الكاسيت الذي سُجِّل لهذا الشيخ، وسافر إلى القاهرة بعد أن زار بغداد».
في القاهرة بدأ بالتدريب على المسرحيّة بكامل ملابسها، وفي اليوم الأخير من التدريبات وجه دعوة للمثقفين والشعراء والكتّاب، ونُقل عن الدكتور المرحوم السيّد مصطفى جمال الدين، الذي كان حاضراً هذه الدعوة، وكان مرافقاً لصديقه الشاعر محمود حسن إسماعيل، قال الدكتور مصطفى جمال الدين: «كنت قد تلقّيت دعوة من الشاعر محمود حسن إسماعيل لحضور مسرحيّة (الحسين ثائراً) و(الحسين شهيداً)، وكنت متواجداً في القاهرة. لقد شاهدت المسرحيّة في أيام شهر رمضان، وبكيت حتى ابتلَّت مناديلي التي أحملها، وصرت أمسح دموعي بِكُمِّ صايتي)» ثم أردف يقول: «لو قُدِّر لهذه المسرحيّة أن تُعرَض في العالم الإسلاميّ لأعطت ثمارها أكثر ممّا عملناه نحن الشيعة طيلة حياتنا». بعد هذا العرض لم تُعرض المسرحيّة إلّا بعد خمس عشرة سنة من المنع، وذكرت إحدى المجلّات الإسلاميّة في التسعينيات أنّ المسرحيّة عادت إلى المسرح بعد أن حُلّ الإشكال بين الأزهر والمخرج، على أن لا تظهر شخصيّة الإمام الحسين×، ولا العقيلة زينب‘([540]).
محاولات لعرض مسرحيّة الحسين ثائراً والحسين شهيداً
جرت محاولات عديدة من أجل عرض مسرحيّة (الحسين ثائراً والحسين شهيداً) من جديد على المسرح في مصر، منها محاولة الفنّان أحمد عبد الوارث تقديم المسرحيّة خلال العام 2012 م، حيث ركّز على مضمون المسرحيّةلإبراز معنى وقيم الثورة، ولماذا يثور الإنسان، وما الذي يدفعه إلى ذلك. وقرّر أحمد عبد الوارث عقد اجتماع مع المؤلِّف الدكتور خالد منتصر الذي سيقوم بإعداد المسرحيّة من مسرحيّتي عبد الرحمن الشرقاوي، ومع المنتج حسين نوح المتحمّس لإنتاج المسرحيّة، إلّا أنّ المشكلة التي تواجه المسرحيّة موقف الأزهر الشريف، الذي يحرَّم ظهور المبشّرين بالجنّة وآل البيت في أعمال فنّيّة، مثلما حدث في العام 1976م عندما اعترض على مسرحيّة الحسين ثائراً لعبد الرحمن الشرقاويّ، والتي أخرجها كرم مطاوع، وقام ببطولتها عبدالله غيث ويوسف وهبي، وتمّ وقفها قبل عرضها بيوم واحد([541]).
من جانبه قام المخرج المسرحيّ المصريّ جلال الشرقاوي سنة 2012م بإعدادٍ مسرحيّ لروايتي (الحسين ثائراً) و(الحسين شهيداً)، وقدّم المشروع إلى مجمع البحوث الإسلاميّة، لكنّ المجمع رفضه، وعندما طلب حيثيّات الرفض أخبره بعض أعضاء المجمع بأنّ الرفض ليس لأسباب دينيّة، ولكنْ لأسباب سياسيّة تتعلّق بأنّ الإعداد الذي قدّمه يبرز رفض الحسين للتوريث في الحكم، بعدما وقّع الجميع لتولية يزيد الخلافة بعد أبيه بالترغيب والترهيب، ولم يبقَ سوى الحسين والحسن، ولهذا السبب ـ والحديث للشرقاوي ـ رُفِضت المسرحيّة لأسباب سياسيّة بحتة، وكتب المجمع في حيثيّات الرفض أنّ هذا النصّ سوف يثير الفتنة النائمة التي لعن الله من أيقظها، وأُغلِق ملفُّ تقديم المسرحيّة منذ يومها.
وأشار الشرقاوي إلى أنّه بعد (ثورة يناير) ارتفع سقف الحريّة ما يجعله يعيد فتح الملفِّ مرّة أخرى، خاصّة بعدما قدّمت سوريا مسلسلاً عن الحسن والحسين، وعُرض في القنوات المصريّة، إضافة إلى إيران أيضاً التي تعرض أعمالاً فنيّة عن سير الأنبياء، وقدّمت أخيراً مسلسلاً عن سيدنا يوسف وفقَ توجّهاتها، وتجهز لفيلم عن الرسول|.
وتابع: «هذه المسرحيّة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق وقدّمها الراحل كرم مطاوع وعرضها ليلة واحدة كعرض بروفة نهائيّة، وظلّ يعرضها لمدّة عشر ليال في السرّ على المسرح القوميّ كبروفة، ولكن بعد علم الجهات الأمنيّة تمّ منع العرض وإلغاء البروفات.
وكشف الشرقاوي عن اتصالات بينه وبين بعض الجماعات الدينيّة والأحزاب لبحث سبل التعاون، ودعاهم إلى لقاءات جماعيّة يشارك فيها أكثر من فنّان حتّى لا يتمّ تحريف كلامه، أو يُضاف إليه ما لم يرد على لسانه([542]).
من جهته قام المخرج المصريّ مراد منير بتعديل نصّ الحسين شهيداً ودمجه مع نصّ الحسين ثائراً، وقدّمه للرقابة لأخذ التصريح بالموافقة، فأرسلت الرقابة النصّ للأزهر، لكنّ الأزهر رفض تجسيد شخصيّة سيّدنا الحسين على المسرح للمرّة الثالثة. فتغيير فكرة اعتراض الأزهر على ظهور الصحابة فى الأعمال الفنيّة كانت الأمل الوحيد لدى مراد منير وكلّ المسرحيّين، وهي في الأساس مربط الفرس، وحلّ هذه المشكلة هو الأمل الأوّل فى تغيير المفاهيم، وهو الإجراء الوحيد لإعادة تحرير الفنون من أفكار تراثيّة.
كان مراد منير قد أوضح أنّه كان يأمل فى موافقة الأزهر خاصّة بعدعرض مسلسل الصدّيق يوسف على قناة ميلودي المصريّة وتجسيد سيّدنا يوسف، لكنّ الأزهر ما زال على موقفه، ورفض مجمع البحوث الإسلاميّة للمرّة الثالثة السماح بظهور الحسين على المسرح.
يضيف مراد: تقديم هذا العمل كان مهمّاً جدّاً لا سيّما وأنَّه يحمل عدداً كبيراً من الرسائل التي أصبحنا بحاجة ملحّة إليها في وقتنا الحاضر، أهمّها أنموذج سيّدنا الحسين نفسه الذي ضحّى بحياته من أجل كلمة، فعندما رفض ولاية يزيد بن معاوية قُتل من أجل كلمة وموقف، وهذا ما نفتقده حاليّاً فى زمن النفاق والتلوّن واللعب على كلّ الأطراف، ولذلك فتقديم هذا العمل حاليّاً يُعدّ ضرورة.
كان الحسين ثائراً وشهيداً على خشبة المسرح حلمَ النجم (المرحوم) نور الشريف الذي كان المرشّح الأوّل لتجسيد الحسين، لكنَّ رفضَ الأزهر والرقابة وأدَ حلم نور الشريف ومراد منير وأشرف زكي الذي كان متحمِّساً للمشروع جداً قبل تركه للبيت الفنّي للمسرح، وتولّى الأمر رياض الخولي الذي أبدى هو الآخر الحماس نفسه، لكنّ الواقع أكَّد أنّهم دخلوا من البداية معركة خاسرة مع الرقابة، مثلما دخل المعركة نفسها من قبل الراحل كرم مطاوع الذي انتهى بالفعل من بروفات المسرحيّة، وكان ينتظر فقط رفع الستار، ولكن لما اشتدت الأزمة مع الأزهر أغلقوا له المسرح ليلة الافتتاح، واضطر مطاوع إلى (التحايل) بعرض المسرحيّة كبروفة جنرال مدّة 30 يوماً على الجمهور قبل إغلاق الملف نهائياً وقتها، قام ببطولتها الفنّان عبد الله غيث وشاركته البطولة سميحة أيوب([543]).
تأثّر الفنان الراحل عبد الله غيث بشخصيّة الإمام الحسين× حين مثّل مسرحيّة (الحسين ثائراً... والحسين شهيداً)، واطّلع على تفاصيل ثورته ومبادئه، وفهمه فهماً عميقاً، وبدأ هذا التأثّر على المسرح حيث أتقن دوره في هذا العمل الدراميّ الذي أبهر به الحضور، ومن بينهم الدكتورة (بنت الشاطئ) الكاتبة المعروفة؛ حيث أُغمي عليها في اثناء العرض من شدّة البكاء في قاعة المسرح.
روى الفنّان الراحل عبد الله غيث أنّه شاهد الإمام الحسين× في الرؤيا، وهو يقول له مستبشراً: (لقد أفرحتنا، وأفرحت عمَّ جدّي الحمزة بدورك المبارك)، وأنّه جعل من هذه الرؤيا وسامَ شرف يعتزّ بها، ويعدّها من أعظم الكنوز الروحيّة لديه، والتي تحصّنه من الانحراف، وتربطه بأهل البيت^، وتغرس فيه روح الإيثار والتضحية والجهاد، وتطهّر قلبه وروحه»([544]).
العقدة المسرحيّة
إنّ ما يظهره الحسين في المدينة قبل توجّهه إلى مكّة، هو أنّه لا ينشد فتنة، ويقول لمن دعاه إلى مبايعة يزيد: «أنا لا أُنشد ملكاً بينكم، فأنا أزهد أهل الأرض في هذا، ـ وإن كان لي الحقّ عليكم – إنّما أنشد أن أُصلح في أمّة جدّي ما استطعت، إنّما أنشد أن أرفع جور الحاكم الظالم عنكم، أنا لا أبغي سوى الإصلاح فيما بينكم، فإذا وُفّقت أُعذرت وإن أفشل عُذرت.. وإذا هم قتلوني دون ما أنشد من خير لكم، فلقد وفّيت لله ديوني وقضيت. اليوم ها أنذا أُحاصَر ها هنا في أرض جدّي، لن يهدأوا عني إذا لم أُعطهم ما يطلبون، ولا أمان إنْ سكتّ».
والحسين يقول قبل توجّهه إلى مكّة: أنا لا أُنشد الملك كما قلت، ولكنّي أُريد الخير للأمّة/ أنا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر.
(الحسين مناجياً الله):
يا ربّ ليس لنا سواك /
أنا لن أضلَّ على هداك /
أنا لن أضيع وهذه الدنيا ملاءة رحمتك/
أنا لن أُذلّ وكبريائي نفحة من عزّتك /
..(مستمرّاً في مناجاة الله):
أنا ذا أخوض المستحيل إلى جلاء حقيقتك /
فأُضِئ طريقي من أشعّة حكمتك /
أنا ذا شهيد الحق ضِعتُ /
لكي أصون من الضياع شريعتك/
لا تُخفِ عن وجهي وضاءة نظرتك /
فالمعجزات يَصِرنَ طوع يد الضعيف
إذا استعان بقوّتك/
إنّي التجأتُ إليك يا ذا الحول والجبروت /
فارزقني الرشاد وشُدَّ أزري /
إنّي نهضتُ أسدّ أبواب الضلال /
فلا معين ولا نصير سوى رضاك /
ولا ملاذ سوى حماك /
فلا تُضِعني
إنّي لنور هُداك قد أسلمت أمري /
قد مات صحبي كلُّهم
وقضى بنيَّ جميعهم /
وبنو أخي.. وجميع إخواني قضوا
وبقيتُ وحدي / أنا ذا الشهيد
دعوتك اللهمَّ ألّا تُقفِر الدنيا العريضة /
من جنود الحقّ بعدي.
كتب عبد الرحمن الشرقاوي مسرحيّته شعراً، فإحدى مقوّمات المسرح ومسرح التعزية بشكل خاصّ هي الشعر. ويرتجز الحسين في أثناء المعركة ويقول:
لقيتْ المسرحيّةُ التي كتبها عبد الرحمن الشرقاوي ومُثِّلت على المسرح القوميّ ترحيباً منقطع النظير من المشاهدين، ولكن تمَّ منعها من قبل السلطات، ووُقف عرضها، ولم تسفر الجهود عن رفع المنع عنها حتّى الان.
قام المخرج كرم مطاوع وهو أحد كبار المخرجين المصريّين بإخراج مسرحيّة (الحسين ثائراً والحسين شهيداً)، ولكنّه واجه منع السلطات للمسرحيّة.
النصُّ
لغة المسرحيّة: الشعر. اقتبس الكاتب مسرحيّته من المصادر التاريخيّة التي لم يذكرها بالاسم، ولكنّه أشار إليها في أواخر مسرحيّته الحسين شهيداً.
ولكنّ النصّ الشعريّ الذي كتبه الشرقاوي يوحي بأنّ الشاعر قرأ كتب التاريخ والمقاتل، وطالع جميع ما كُتب عن الحسين، ولا سيّما أقواله وأراءه منذ أن خرج من المدينة متوجّهاً إلى مكّة ووصوله إلى مكّة، وخروجه منها إلى العراق، ووصوله إلى أرض كربلاء، وكلّ ما قاله الحسين في كربلاء في محاورته لأصحابه وأهل بيته، وفي مواجهته لقادة جيش يزيد ومنهم عمر بن سعد.
لقد اكتسبت المسرحيّة شخصيّتها اللغويّة والبيئيّة، وميّزتها من ألوان الأدب المسرحيّ المتأثر بتيارات الغرب والشعر الملحميّ الإغريقيّ، وتمكّن الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي أن ينطلق، ويحلّق بالكلمة البلاغيّة نحو الإبداع والسموّ المشحون بالعاطفة؛ لأنّه يمتلك القدرة على التصوير، ويتفاعل مع الأحداث باندماج كليّ، يعينه بذلك فهمه الثقافيّ وثروته اللفظيّة من اللغة التي يمتلكها، إنّه عالج موضوعاً تاريخيّاً شغل بالَ كلّ المسلمين الأحرار الذين اتخذوه طريقاً للخلاص على مرّ الأجيال، كذلك تأثّر به غير المسلمين من طالبي الحريّة في العالم، لقد رسم الخصوصيّات من خلال تشابك واضطراب حاضرنا الذي ساده الظلم والإضطهاد والقمع.
إنّ تاريخنا الإسلاميّ مَعِينٌ لا ينضب؛ يستطيع كتّابنا المسرحيّون أن ينهلوا منه الكثير؛ لخصوبته ولدلالاته الحيويّة التي تعيش متجدّدة ما دام الإسلام ينشر فكره المشرق المتجدّد في كثير من مناطق العالم.
ويستمرّ الكاتب عبد الرحمن الشرقاوي في نهاية الجزء الأوّل بحواره المتماسك وبسموِّ الكلمات، وتستمرُّ المسرحيّة بدفقاتها وإيقاعها الشعريّ تلفت نظر الجميع قارئين ومشاهدين.
إنّ هذه الدراما الشعريّة المأساويّة تجسّدت في مشهدها الأخير الذي لفت نظر الغافلين واللاأباليّين من جهة، والثائرين المطالبين بالعدالة من جهة أخرى، أن يسيروا على منهج جدّه| وأبيه× ومنهجه×، ويذكروا ثأره؛ لأنّه ضحّى من أجلهم ومن أجل الأجيال التي تَلَتْهُم، ومن أجل قضيّة أزليّة تخصّ البشريّة جمعاء.
في هذا المشهد ألغى الكاتب الحاجز الزمنيّ بين الماضي والمستقبل، عندما جسّد صوت الحسين حاضراً في مجلس المختار، طالباً الثأر بدمه، ونبّهه إلى مصيره ومصير الأمّة الإسلاميّة، وامتدّ هذا النداء إلى الحاضر والمستقبل؛ ليكون الحجّة إلى يوم الدين. لقد نبّه الأمّة إلى وجود الحكّام المستبدِّين والمنحرفين فيها الذين يهدمون كيانها؛ ليسهل ابتلاعها.
تختلف مسرحيّة (الحسين ثائراً والحسين شهيداً) عن المسرحيتين السابقتين حيث تتضمَّن فصلاً عن المختار بن يوسف الثقفيّ، وكيف أنّه أخذ ثأر الحسين بقتله جميع من شاركوا بقتل الحسين، ومنهم عبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد، والشمر بن ذي الجوشن.
المشهد الأخير من المسرحيّة يبدأ بسقوط يزيد خلف إحدى الصخور، بينما ترتفع نداءات من بعيد.. ويدخل رجال يملأون المكان وعلى رأسهم المختار، والحسين× يقف على الربوة مشرفاً عليهم في جلال، وسط هالة الضوء الغريب.
«الرجال: يا لثارات الحسين... يا لثارات الحسين بن علي...
المختار: قد أخذنا فيه ثارَ الله من كلّ الطغاة، نحن لن ننسى الحسين بن علي.
الرجال: يا لثارات الحسين... يا لثأر الله... يا لثأر الحسين...
المختار: (للرجال) اُذكروا الله كثيراً، واُذكروا ثأر الحسين فهو ثأرُ الله فينا..
الحسين×: فلتذكروني لا بسفككم دماءَ الآخرين..
بل اُذكروني بانتشالِ الحقّ من ظُفر الضلال..
بل اُذكروني بالنِّضال على الطريق؛ لكي يسودَ العدلُ في ما بينكم..
فلتذكروني بالنضال..
فلتذكروني عندما تغدو الحقيقةُ وحدَها
حيرى حزينة
فإذا بأسوارِ المدينةِ لا تصونُ حِمى المدينة
لكنَّها تحمي الأميرَ وأهلَهُ والتابعين
فلتذكروني عندما تجدُ الفصائلُ نفسَها
أضحتْ غريبة
وإذا الرذائلُ أصبحتْ هي وحدَها الفُضلَى الحبيبة
وإذا حكمتم من قصورِ الغانِيات
ومن مقاصيِرِ الجَواري
فاذكروني
فلتذكروني حينَ تختلطُ الشجاعةُ بالحماقة
وإذا المنافعُ والمكاسبُ صرنَ ميزانَ الصداقة
وإذا غدا النبلُ الأبيُّ هو البَلاهة
وبلاغةُ الفصحاءِ تقهرُها الفَهاهَة
والحقُّ في الأسمالِ مشلولُ الخُطى حَذَرَ السيوف!
فلتذكروني حينَ يختلطُ المزيَّفُ بالشريف
فلتذكروني حينَ تشتبهُ الحقيقةُ بالخيال
وإذا غدا البهتانُ والتزييفُ والكذبُ
المجلجلُ هُنَّ آياتُ النجاح
فلتذكروني في الدموع
فلتذكروني حينَ يستقوي الوضيع
فلتذكروني حينَ تغشى الدِّينَ صيحاتُ البطون
وإذا تحكّم فاسِقُوكُم في مصيِر المؤمنين
وإذا اختفى صَدْحُ البلابل في حياتِكم
لِيرتفعَ النباح
وإذا طغى قَرْعُ الكؤوس على النّوَاح
وتجلجلَ الحقُّ الصِراح
وبذاك تنتصرُ الحياة
فإذا سكتّم بعدَ ذلك على الخديعة
وارتضى الإنسانُ ذِلَّه
فأنا سأُذبَحُ من جديد
وأظلُّ اُقتَلُ من جديد
وأظل أُقتَلُ كلَّ يوم ألف قتلة
سأظلّ أُقتَلُ كلّما سكتَ الغيور وكلّما أغفا الصبور
سأظلّ أُقتَلُ كلّما رُغِمت أُنوفٌ في المذلّة
ويظلُّ يحكمُكُم يزيدُ... ويفعلُ ما يريد
وولاتُه يستعبدونكم وهم شَرُّ العبيد
ويظلُّ يلقِّنُكم وإن طالَ المدى جرحُ الشهيد
لأنّكم لم تُدرِكُوا ثأرَ الشهيد
فاذكروا ثأرَ الشهيد»
وهكذا كانت نهاية هذا المشهد الدراميّ على لسان أبي عبد الله الحسين× والمشحون بالعاطفة والتذكير، وهو تصوير دقيق لنداء الحقّ والعدل، وصيحة تبقى للأجيال القادمة([545]).
الفصل الثالث
تعزية عرس القاسم تُعَدُّ من أشهر عروض التعزية في إيران، وتتناول كتب التعزية بالفارسيّة (عرس القاسم) عند ذكر واقعة كربلاء، وتشير إلى أنّ الحسين بن علي أمر بإقامة عرس القاسم بن الحسن يوم عاشوراء، وهو مُحاط بالأعداء. ولكنّ عدداً من علماء الدين الإيرانيّين ـ ومنهم الشيخ عبّاس القمي، وآية الله مرتضى مطهّري ـ يفنِّدون قصّة (عرس القاسم) يوم عاشوراء، ويرون أنّه من تحريفات واقعة عاشوراء، مبرزين دلائل وأسباب رفضهم لهذه القصّة. ونحن لا نورد المسرحيّة هنا مؤيّدين ما ورد فيها، وإنّما نوردها كعملٍ مسرحيّ فحسب.
عرس القاسم واختلاف الكتّاب حوله
اختلف الكتّاب والعلماء الشيعة حول حقيقة (عرس القاسم) فمنهم من أنكر الروایة، ومنهم من أيّدها، ومن هؤلاء الشيخ فخر الدين الطريحي في كتابه (المنتخب).كما ذكر بعض الكُتّاب أنّ رواية عرس القاسم قد ذُكرت قبل الطريحي، وأنَّ عدم وجود رواية ما ضمن كتب المقاتل المعتبرة لا يجعل الرواية مكذوبة أو مختلقة؛ لوجود كتب كثيرة كانت موجودة عند من سبقنا ومفقودة الآن، بل إنّ هناك الكثير من المخطوطات التي لم تَرَ النور حتى الساعة، وكثيراً ما تنفرد تلك المخطوطات بعد تحقيقها وطباعتها بخصائص تميّزها عمّا عداها.
ويرى السيد عبد الرزاق المقرم في كتابه (مقتل الحسين) أنَّ رواية عرس القاسم مدسوسة في كتاب المنتخب وموضوعة عليه، وقال: «الشيخ فخر الدين الطريحي عظيم القدر، جليل في العلم، فلا يمكن لأحد أن يتصوّر في حقّه هذه الخرافة، فثبوتها في كتابه (المنتخب) مدسوسة في الكتاب، وسَيُحاكِمُ الطريحي واضعها في كتابه!»([546]).
إلّا أنّ قصّة عرس القاسم نقلها قبل الطريحي بما يقرب من مائتي عام الكاشفي المتوفَّى في العام 910هـ، حيث نقلها في كتابه (روضة الشهداء)، ومن الجائز أنّ البعض قام بترجمة ما ذكره الكاشفي، ثم قام الطريحي بنقله إلي كتابه.
يقول هاشم الهاشمي تسويغاً لرواية عرس القاسم: «إنَّ رواية عرس القاسم لم تنقل قبل كتاب (روضة الشهداء) للكاشفي في كتب المقاتل والتاريخ، ولو كانت موجودة لأشار إليها ـ ولو على نحو الإجمال ـ مَن سبقه ممّن كتبوا في مقتل الإمام الحسين×. ومن الجائز أن يكون الكاشفي قد عثر على بعض الكتب التي فيها قصّة عرس القاسم ثم نقلها في كتابه، وليس المطلوب أكثر من هذا الاحتمال، وهو وارد ولا يمكن الجزم بعدمه، ومن يدع ذلك فليأتِ بالدليل»([547]).
ويرى الهاشمي بإنّ وجود كتب عند بعض السابقين مفقودة الآن ليس بالأمر الغريب، ومن باب التأكيد نشير إلى أنَّ الشيخ الكفعمي المتوفّى بعد العام 895هـ (أي أنّه يُعَدّ معاصراً للشيخ الكاشفي المتوفّى في العام 910هـ) نقل في كتابه (مجموع الغرائب وموضوع الرغائب) عن كتب كثيرة مفقودة الآن من قبيل (غرر الجواهر والمثالب ومطالع الأنوار وآداب النفس وغيرها)، فما وجه الاستبعاد أن يكون معاصره الكاشفي قد عثر على رواية عرس القاسم في بعض الكتب التي كانت عنده من كتب السابقين؟([548]).
يُقال أنّ الإمام الحسين× طلب من أمّ القاسم ثياباً جديدة للقاسم بن الحسن، لأنّ الإمام الحسين× كان يعلم بأنّ القاسم× سيُستَشهد، ولبس جديد الثياب عند قصد لقاء الله تعالى أمر حسن، وعندما لم تتوفّر تلك الثياب ألبسه لباس أبيه، ولعلَّ ذلك اللباس ممّا كان يحتفظ به الإمام الحسين× من ملابس أخيه عندما كان صغيراً أو أنّه تمّ جمعه أو تقصيره.
إنّ أكثر الخلط الحاصل عند المعترضين على قصّة عرس القاسم هو ما يقوم به المحبون من مراسم تذكارية، من قبيل توزيع الحلوى أو نثر المكسَّرات وإشعال الشموع وغير ذلك ممّا يتناسب مع أجواء العرس الحقيقية، فيظنون أنّ الذي وقع في كربلاء هو من هذا القبيل، على الرغم من أنّ قصد المحبِّين هو تهييج القلوب حيث إنّهم يقرأون مع تلك المراسم أشعاراً حزينة حول حرمان القاسم× من العرس والزواج، وهو في مقتبل العمر، وأنّ خضاب العرس هو الدماء المنبعثة منه، وهذا يهيِّج المصيبة في قلوب السامعين والناظرين، ولا يعني أنّ القاسم لم يكن له همّه إلّا العرس كما يقول الشهيد المطهري، فالقاسم وكما تذكر رواية العرس نفسها وبعد عقد زواجه على بنت الإمام الحسين× مباشرة، خرج نحو الميدان لنصرة عمِّه حين سماعه طلب البراز([549]).
كما أنّ هناك سبباً شكليّاً آخر يدعو المعترضين إلى الاستنكار، وهو استعمال تعبير العرس الذي يوحي بالفرحة غير المتناسبة مع أحزان ومصائب كربلاء، وهذا التعبير درج عليه عامّة الناس كإشارة إلى إحدى الجهات المهيِّجة في المصيبة، لا أنَّ هناك عرساً وقع في كربلاء، فرواية الطريحي نفسها صريحة بقول القاسم: «عرسنا أخّرناه (أي أجّلناه) إلى الآخرة»، فهل هناك تصريح أوضح من هذا في نفي حصول العرس وتأجيل العرس إلى الآخرة؟ إنّ الفتى مات قبل أن يهنأ بشبابه. لقد وصفت كتب المقاتل القاسمَ بن الحسن بأنّه كان غلاماً لم يبلغ الحلم، أي إنّه لم يبلغ سنّ الزواج، فكيف تصحّ نسبة الزواج إليه؟
إنّ تحويل التاريخ الحقيقيّ إلى أسطورة، مصدره تحويل العوام الرموز والصور في الشعر إلى حقائق، ففي الشعر تُستخدم لفظة العريس الذي لم يهنأ بعرسه، كناية عن موت الشاب أو الفتى قبل زواجه، فعدّها الراوي حقيقةً مفروغاً منها. إنّ المصدر الأصليّ لعرس القاسم هو ما ذكره ملا حسين واعظ الكاشفي السبزواري في كتاب (روضة الشهداء)، ومن الضروري النظر في مدى تطابق الموجود في (المنتخب) وكتاب(تحفة اللباب) للشدقمي مع تعريب للنصِّ الفارسيّ الأصليّ للقصّة من كتاب (روضة الشهداء)؛ إذ إنَّ المقارنة بينها تسلّط الضوء على تحديد المصدر الأصليّ، ومستوى الترجمة مضافاً إلى النقطة الأهمِّ، وهي أنّ تعدّد الترجمات لم يغيِّر من المحتوى الأصليّ للقصّة، فكلّها متقاربة من حيث المضمون إلى حدٍّ كبير جدّاً.
إنّ الكاشفي اعتاد في كتابه (روضة الشهداء) على نقل وقائع كربلاء بأسلوب أدبيّ فارسيّ، يطعّمه أحياناً بأبيات من الشعر وبقصص خياليّة. قال الكاشفي ما ترجمته عن عرس القاسم:
يقول الراوي:
«لما نظر القاسم بن الحسن× إلى وجه أخيه الذي كان زهرةً وادعة في الروض وقد ذبلت بشوكة تلك الحادثة الفتّاكة تأوّه وأقبل نحو عمّه العزيز، وقال باكياً وقد احترق قلبه من نار الحسرة: يا مولاي ويا إمام الكون، ليس لي طاقة على فراق الأهل (الأحبة)، ولقد أنزلني الزمان من سرير بهجتي إلى تراب الغمّ والمصيبة، فأذنْ لي كي أنفّس عن الغِلّ (الألم) الذي خلّفه مقتل أخي؛ ولكي أجيب طلب أهل الضلال بحدّ السنان، فقال الإمام الحسين×:
يا عزيز عمّه، إنّك الذكرى من أخي، وأنت أنيس قلبي في هذه الصحراء، فكيف آذن لك وأحمل حرقة فراقك في صدري؟ وخرجت أمُّ القاسم من الخيمة مهرولة، وقد احتضنت بيديها ولدها وصاحت: يا مَن حلّ محلَّ قلبي ارفق بي، ولا تبتعد عن ناظري ولأنّك دواء قلبي فكن دواء عيني».
تقول الرواية: «أنّ القاسم لم يحظَ بإذن الحرب، وكان إخوة الحسين يستعدّون لخوض المعركة، فجاء القاسم إلى الخيمة، ووضع رأسه على ركبتيه مهموماً، وحينها تذكّر أنَّ أباه قد ربط تعويذة على ساعده، وكان قد أخبر: حين يشتدُّ عليك الغمّ ويحيط بك اليأس، فحلّ هذه التعويذة واقرأها، وأعمل بما فيها، فقال القاسم لنفسه:طوال حياتي لم أمرَّ بمثل هذه الحال، ولم يلمّ بي غمّ كهذا، لأقرأ هذه التعويذة، وأفهم ما فيها، فحلّ رباط التعويذة وفضّها، فرأى مكتوباً فيها وبخطّ يد الإمام الحسن×:
(قاسم أوصيك إذا رأيت أخي وعمَّك الإمام الحسين× في فلاة كربلاء، وقد ابتُلي بأهل الشام الملاعين وأهل الكوفة الغادرين، فانهض وضع رأسك عند أقدامه، وابذل روحك رخيصة، وكلّما منعك من القتال معه فبالغ في طلبك، وزد من إلحاحك، فإنّ فداء الحسين× مفتاح باب الشهادة، وطريق لإدراك السعادة).
حينما قرأ القاسم هذه الوصية لم يتمالك نفسه من شدّة الفرح، فنهض من مجلسه على الفور وتوجّه نحو الإمام الحسين× وهو يقبّل تلك التعويذة حال تسليمها، وحينما نظر الإمام الحسين في تلك الرسالة، زفر وتأوّه، وانتحب بصوت عال، ثمّ قال: يا ابن الأخ، إنّ هذه وصيّة أبيك إليك، وأنت تريد العمل بها، وإنّ لي وصية أخرى منه لك، وإنّني أريد العمل بها، فتعالَ معي إلى هذه الخيمة، ولنعمل بتلك الوصية، ثمّ أخذ بيد القاسم إلى الخيمة، وقال لأمِّ القاسم: ألبسي القاسم ثيابه الجدد، وقال لأخته زينب: ائتيني بعيبة أخي في الحال، فأحضروه له ففتح رأس الصندوق، وأخرج منه قباءاً ثميناً للإمام الحسن× وألبسه القاسم، ووضع على رأسه عمامة الإمام الحسن× بيديه المباركتين، وطلب إخوته عوناً والعبّاس، وأخذ بيد البنت المسمّاة للقاسم، وقال: وإنّ هذه أمانة أبيك التي أوصاك بها، ولقد كانت عندي حتى هذه الساعة سلوة، ثمّ عقد له على ابنته، ووضع يدها بيد القاسم، وخرج من الخيمة، وكان القاسم ممسكاً بيد زوجته، يبكي وهو ينظر إلى وجهها، ثم يومئ برأسه نحو الأرض، وإذا به يسمع صيحة من جيش عمر بن سعد: هل من مبارز؟ رفع القاسم يده عن يد زوجته وأراد الخروج من الخيمة، فأمسكت زوجته بذيله، وقالت: يا قاسم، ما الذي يدور في خَلَدك؟ وإلى أين أنت عازم؟
قال القاسم: يا نور عيني، إنّني عازم على الميدان، وهمتي محاربة الأعداء، فاتركي ذيلي فإنّ عرسنا قد تأجّل إلى الآخرة.
فقالت الزوجة: إنّك تقول إنَّ عرسنا قد تأجّل للقيامة، فأين ألقاك في غد القيامة؟ وبأي علامة أعرفك؟
فقال: اطلبيني عند أبي وجدّي، واعرفيني بهذا الكُمِّ المقطوع، ثم مدّ يده وقطع كمّه وخرج عن زوجته مسرعاً»([550]).
وقد سأل العديد من الشيعة من أهالي منطقة الخليج آية الله الشيخ الميرزا جواد التبريزي([551]) عن تخصيص اليوم الثامن من شهر محرّم من كلّ عام لشبيه القاسم بن الحسن×، لإثارة الندبة والنواح، ويطرح الخطباء على المنابر مصيبته، وينقلونها حسب ما ذكره المؤرّخون، ومنها زواجه بابنة عمّه المسمّاة له في يوم الطفِّ، وربّما يدخلون ما يعبّر عن مراسم الزواج كالشموع في وسط المجلس، فيزداد حزن الناس، إلّا أنّه في عصرنا الحاضر كثر المعترضون على مثل هذه الروايات والتعبير عنها بالضعف، بل بلغ الأمر إلى الاستشكال في قراءة مثل هذه الرواية، فبمَ تنصحون أمثال هؤلاء حيث إنَّ مصيبة الطفِّ جامعة لكلّ المصائب؟.
فأجاب آية الله التبريزيّ بالقول:
«بسمه تعالى: لا بأس بقراءة هذا المجلس على القاسم بن الحسن×، ولكن حسب ما ورد في الكتب التاريخيّة، بحيث لا تكون قراءته على نحو يترسّخ في أذهان الناس أنّها حتميّة الحصول، بل على نحو الاحتمال، والمسائل المتيقّنة والمطمئن بها غير قليلة، فليكن الاهتمام بها أكثر لتُرسَّخ في الأذهان للأجيال القادمة؛ لدفع الشبهات التي تحيط بهم، والله الموفق»([552]).
انتقال طقوس تعزية عرس القاسم من إيران إلى العراق
لا شكّ أن قصّة عرس القاسم انطلقت من إيران، وكان الملا حسين واعظ كاشفي أوّل من طرحها في كتابه (روضة الشهداء) وقد رافقت تعزية عرس القاسم التي كانت تُقام في المدن الإيرانيّة طقوس متعدّدة، منها حمل الشموع والحناء، وغرفة مدورة أو مثمّنة الأضلاع مزيّنة بالشموع والمصابيح تسمّى (حجله قاسم) [غرفة زفاف القاسم] تُحمل ليالي عشرة محرّم مع مواكب العزاء. وقد انتقلت هذه الطقوس من إيران إلى العراق. وكان العراقيّون في الستينات من القرن الماضي يحملون في ليالي العشرة الأولى من شهر محرّم الشموع والحناء وغرفة خشبية تسمّى (حجله قاسم) [غرفة زفاف القاسم] في إشارة إلى إقامة عرس القاسم. وهذا ما شاهده الباحث في مدينة كربلاء في الستينات من القرن الماضي.
ويشير لطيف حسن في كتابه (فصول من تاريخ المسرح العراقيّ) في فصل: (كربلاء وتشابيه المقتل والتعازي الحسينيّة في عاشوراء) إلى نوع من الممارسة الدراميّة يُسمَّى (عرس القاسم)، شخصيّاتها كلّها نسائيّة، تلبس إحدى النساء فيها ملابس العرس وتضع البرقع الأبيض على وجهها لتودّع القاسم، وتوقد فيها (صواني الشموع والياس وحلوى العرس)([553]).
رواية مستشرق فرنسيّ عن عرض تعزية عرس القاسم في طهران([554])
عاش أوستاش دولورى (Eustache de Lorey) سفير فرنسا في بلاط مظفّر الدين شاه (1313 ـ 1324هـ/1885 ـ 1896م)، عامين في إيران، وبعد عودته إلى بلاده كتب مذكّراته في كتاب بعنوان (عجائب إيران) وشرح في جانب منه (مجالس التعزية)، ومنها مجلس تعزية القاسم، وطُبع الكتاب سنة 1907م.
ويقول الكاتب: «إنّ الإيرانيّين يقضون أهمّ اللحظات بإقامة مجالس التعزية. ويعتقد أنّ التعزية هي عرض مسرحيّ دينيّ كبير، تُقدّم فيه واقعة استشهاد أهل بيت الإمام عليّ، وهدف ذلك التعليم والتهذيب الدينيّ والأخلاقيّ للشيعة المتديّنين»، ويضيف: «إنّ الذين يقومون بدور القتلة (الأشقياء) في هذه العروض ينسون أنفسهم ويبكون على استشهاد الإمام كما يفعل المشاهدون...».
ويرى الكاتب بأنّ عروض مسرح التعزية تُقام في أماكن خاصّة، وتُسمَّى (التكية) وأكبر هذه التكايا (تكية دولت) التي بنيت ضمن عمارات البلاط. ويضيف أنّ ناصر الدين شاه القاجاريّ بنى تكية دولت وقد أُقيمت فيها عروض التعزية لمدّة قصيرة خوفاً من انهيار المبنى. شاهد أوستاش دولوري عروض التعزية في بيوت رجال البلاط في طهران، وكان يرافقه معلّمه واسمه ميرزا على أكبر خان. وكانت باحة الدار المكان الذي كانت تقام فيها عروض التعزية. ويقول دولوري بأنّه شاهد أفضل عروض التعزية وهو عرض تعزية (عرس القاسم) في بيت أحد وزراء مظفّر الدين شاه القاجاريّ.
يصف الكاتب البيتَ الذي اُقيم فيه عرض تعزية عرس القاسم، ويقول: «أُقيمت خيمة في باحة الدار، ووُضع غطاء خشبيّ على حوض كان في وسط الدار، وصُنعت مصطبة، وضعت عليها سجادات وعلى جانب المصطبة، وضعت المرايا والمصابيح والفوانيس والصور، التي جلبها الجيران، كما أنّ الناس غير الميسورين كانوا يجلبون معهم أشياء (هدايا) صغيرة من أجل المشاركة في التعزية»([555]).
وُضعت المصابيح والثريات وباقات الورد في أماكن من الدار من أجل الزينة، ووضعت خلفها صورٌ ومرايا. وُضع في باحة الدار منبر، غطّي بقماش من نوع الكشمير، وكان النائح يقف على المنبر، كما فُرشت باحة الدار بالسجاد، وجلس عليها المواطنون من مختلف طبقات الشعب غنيّهم وفقيرهم. وجلس النسوة المحجبات والمنقّبات في جانب من الدار، وجلس الرجال في الجانب الآخر. جلس صاحب الدار والضيوف في الغرف المطلّة على الباحة، وجلستُ أنا (السفير الفرنسيّ) مع الضيوف.
يشير السفير الفرنسيّ إلى أنّ الإيرانيّين لا سيما عامّة أبناء الشعب لا يكنّون الودّ للأجانب، وهم يغضّون الطرف عن مشاركة الأجانب في مجالس العزاء، بسبب قدسيّة المكان وقدسيّة هذه المجالس. ويتطرّق دولوري إلى أنّ كتّاب مجالس التعزية غير معروفين، وأنّ كتاب هذه المجالس عديدون. ولكنَّ الأشعار التي يرى البعض أنّها ضعيفة وليست بالمستوى تُحذف وتوضع مكانها أشعارٌ أفضل. يرى دولوري بأنّ رجال الدين الكبار يعارضون إقامة مجالس التعزية، ولا يرون أنّها مقبولة، ولكنَّ الذين يقومون بإجراء التعزية يحظَون بالاحترام؛ لأنّ هؤلاء يقومون بدور شخصيّات مقدَّسة تحظَى باحترام الناس.
ويشير دولوري إلى أنّ الممثّلين يعملون تحت إشراف رئيس يُطلَق عليه اسم أستاد. فالأستاد([556]) هو من يقوم بدور المخرج، يصدر تعليماته للممثّلين، ويجهّزلهم ما يحتاجون إليه، ويقدّم إليهم الإرشادات عندما يراهم لا يقومون بأدوارهم خير قيام. ويشرح المخرج للمشاهدين نقاطاً غامضة لم يدركوها. وخلاصة الأمر فإنّ المخرج هو الذي يحلّ المشاكل ويسهّل أمور التعزية، فالمخرج يعمل كلّ جهده؛ لكي يقوم بدوره بأحسن وجه([557]).
يقول دولوري إنّ تعزية القاسم تحظَى بإقبال جماهيريّ كبير، وتغصّ الدار التي يُقام فيها المجلس بالمشاركين. ويبدأ مجلس التعزية بالنفخ في المزامير والضرب على الطبول، وتدخل مجموعة من المعزِّين إلى باحة الدار، وهم يلطمون صدورهم وينادون ياحسين يا حسين. فالمشاهدون لم ينزعجوا من هذا الوضع، وقد دخل إلى المصطبة الأستاذ الذي يقوم بإخراج مجلس التعزية، وأحضر معه جلد الأسد ليذكِّر المشاهدين بالصحراء، وكذلك جاء بسيوف وخوذات وأعلام نصبها حول المصطبة. كما وضع في جانب من المصطبة أكواماً من القشِّ، ليُري الناس بأنّ المكان يشبه الصحراء، ويقوم الممثّلون بنثر القشّ على رؤوسهم ليُظهروا حزنهم وعزاءهم. ووُضِع إلى جانب من المصطبة إناء كبير من الفضة مليء بالماء؛ ليدلّ على نهر الفرات. وخلال إعداد المقدّمات لإجراء مجلس تعزية عرس القاسم، كان شبّان يسقون الماء للمشاهدين بواسطة قِرَب صُنِعت من جلد الماعز، حملوها على ظهورهم تذكيراً بعطش الحسين وأصحابه.
بعد ذلك، عزفت الفرقة الموسيقيّة قطعة من الموسيقى الصاخبة، دخلت إثرها مجموعة من الممثّلين بينهم نجمٌ يسير أمامهم، وهذا النجم هو شاب جميل المحيّا فارع الطول، قد اُختِير من بين أفضل قرّاء التعازي، ويقوم هذا الشاب بتمثيل دور القاسم بن الحسن بطل التعزية. ووقف الشخص الذي سيمثّل دور الإمام الحسين إلى جانبه، وهو رجل طويل القامة يلبس ثوباً أخضر، ويضع عمامة خضراء فوق رأسه ويغطّي وجهه. ويقوم رجال بدور نساء كبيرات السِّنِّ، كما يقوم فتيان بدور النساء الشابات.
جلس شبيه الحسين على كرسيّ مغطَّى بالمخمل، وغطّى وجهه بهالة من نور المصابيح، وجلس شبيه القاسم أمام الحسين على سجّادة من الأبريسم، وجلس الممثّلون الآخرون على المصطبة، وجلست عروس القاسم فاطمة إلى يمين عمّتها زينب، كما جلست أمُّ القاسم زوجة الحسن بن عليّ، وكذلك أمّ ليلى زوجة الحسين بي بي شهربانو أمُّ علي بن الحسين زين العابدين على المصطبة.
جلس إلى جانب أمِّ ليلى ولد سيمثّل دور على الأكبر ابن الإمام الحسين، الذي استُشهد في كربلاء عندما اقترب من نهر الفرات، واستُشهد بسهام العدو. كما جلس رجل يمثّل العبّاس بن عليّ أخا الحسين على المصطبة، وعليه ثوب مغطّى بالدم، وعُلِّقت سهام بهذا الثوب؛ ليُدلَّ على استشهاده في أرض المعركة([558]). كما جلس عدد من الصبية لا تزيد أعمارهم عن أربع سنوات على المصطبة، ويبدو على وجوههم الحزن والكآبة.
في جانب من المصطبة جلس الخليفة يزيد، وأعضاء بلاطه ونساؤه وقادة جيشه، بينهم اثنان من كبار القادة، وهما عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن. وقد لبس هؤلاء أفخر الملابس. وعُلِّقت النياشين والأوسمة وقطع من الذهب على جبّة يزيد، ولبست نساؤه أفخر الملابس الأوروبيّة؛ ليتمّ إظهارهنّ بمظهر النساء البغيضات الملعونات. ودخل قادة جيش يزيد إلى المصطبة معلنين تواجدهم إلى جانب يزيد ونسائه وأصحابه.
هنا بدأ مجلس التعزية، وقام قارئ من القراء بشرح الواقعة بصوت جَهْوَري، وكان في يده ورقة على شكل عريضة، وعندما بدأ القاسم المعركة كان الحسين يطلب من أصحابه الدعاء له، بعد سويعات من مشاركته في مراسم العرس. وهنا يبدأ الحسين بالدعاء للقاسم، رافعاً يديه إلى السماء، بينما نساؤه وأهل بيته رافعات نسخاً من القرآن على رؤوسهنَّ، كما بدأ المشاهدون الدعاء بصوت عالٍ للقاسم.
ويشير دولوري إلى أنّ أعضاء الفرقة قاموا في نهاية العرض بالوقوف صفّاً واحداً والدعاء جماعة؛ لأنَّ الدعاء في آخر العرض هو عادة تجري في ختام مجالس التعزية. وينهي دولوري وصفه للتعزية بالقول بأنّ المشاهدين لم يظهروا خلال العرض أيَّ فرح وتصفيق، بل إنّ نجاح مجلس التعزية يُقاس بالدموع التي يذرفها المشاهدون، وشدّة بكائهم ونحيبهم خلال العرض([559]).
مسرحيّة تعزية عرس القاسم بالعربيّة([560])
تُقام مسرحيّة عرس القاسم في المدن الإيرانيّة، وخاصّة في التكايا والحسينيّات والبيوت، وهذه المسرحيّة من أشهر المسرحيّات التي تُمثَّل في هذا العصر بمناسبة استشهاد الحسين في يوم عاشوراء.
تُعدُّ مسرحيّة (عرس القاسم) من أشهر المسرحيّات التي تُمثَّل في إيران. وتتضمّن الكتب التي تضمُّ مسرحيّات عاشوراء مسرحيّةَ القاسم؛ لما لها من تأثير على المشاهدين. توسّع كتّاب المسرحيّات في كتابة مسرحيّة عرس القاسم، وأضافوا إليها مواضيع جديدة، منها ما دار بين القاسم وخطيبته قبل توجّهه إلى ساحة القتال، وهذا يظهر أن كتّاب المسرح لم يأخذوا القصّة التي رواها الملا حسين واعظ كاشفي في كتابه (روضة الشهداء) عن عرس القاسم بخذافيرها، بل أضافوا إليها جملاً بعيدة كلّ البعد عن الحالة التي كان عليها القاسم، وظروف المعركة يوم عاشوراء.
شارك القاسم بن الإمام الحسن بن عليّ بن أبي طالب في معركة كربلاء إلى جانب عمّه الحسين بن عليّ. القاسم طلب الإذن من عمّه الحسين؛ ليشارك في الحرب ويقاتل أعداء الحسين من جيش يزيد. ولكنّ ابن عمه عليّ الأكبر كان قد استُشهد توّاً.
الحسين لا يرى الفتى مؤهّلاً لدخول الحرب؛ لأنّه لم يصل بعدُ إلى السنّ التي تسمح له بخوض القتال.
القاسم حزين؛ لأنّه يريد أن يثبت لعمّه بأنَّه أهلٌ للقتال. إنّه يدعو أخاه عبد الله، وهما يندبان وينوحان؛ لأنّ الحسين لا يسمح لهما بخوض القتال، فهما يعدّان نفسيهما يتيمين.
أُمّ القاسم تنظر وترى ولدها حزيناً باكياً، وتسأل ابنها لماذا هو حزين؟ وتقول له: «لا تبكِ يا بنيَّ، فداك أُمُّك، اذهب وخذ إذن (الجهاد) من ذلك المقتدَى (الحسين)». يردُّ القاسم على أُمّه قائلاً إنّ الحسين يرفض منحه إذن الدخول إلى ساحة القتال.
الأمّ تُعزّي ابنها وتقول له: «الحسين هو ناصر كلّ حزين». القاسم يرجو أمّه أن تذهب إلى عمّه الحسين، وتأخذ منه الإذن له؛ لكي يخوض القتال.
تذهب أمُّ القاسم إلى الحسين، وتطلب منه الإذن لولدها، ولكنَّ الحسين يرفض ويقول لها:
«... هو ابن الحسن وذكراه لنا
وهو طفلٌ لم يرَ الدنيا
وهو برعمٌ لم يتفتّحُ في حديقة الدهر
كيف أمنحه إذن القتال مع جيش لعين؟
فنيرانُ حزنِه تحرقُ الأرضَ والسماء...».
ولكنََّ الحسين يغيّر رأيه متأثِّراً بدعوات أُمِّ القاسم وتوسّلاتها له ويقول:
«إنَّني أأذن للقاسم نيابة عن أبيه الحسن؛ لكي أخفّف من حزنه، اذهبْ وهيّء بأسرع وقت مقدّمات عرسكَ».
فالعبارة الأخيرة، تجعل الأمّ ترتعدُ وتندهشُ كثيراً.
الحسين يدعو أخته زينب. وزينب حزينة جدّاً وتقول:
« عليّ الأكبر غارق في دمه..
هل الوقت وقت العرس والفرح والسرور؟..!!».
يردّ الحسين عليها بالقول:
«الحسنُ كان يرغبُ أن يرى عرسَ القاسم
ما حيلتي وقد أوصى إليّ أن أقوم بهذا الأمر.
فنور شمع المحفل دَيْنٌ للإمام الحسن
وهو حزينٌ في أرض كربلاء
اذهبوا جميعاً مع الأهل والحرم
وأخبروا فاطمة بالخبر السارِّ».
تذهب زينب إلى فاطمة (بنت الحسين) وتخبرها بما يريد منها أبوها، لكنّ فاطمة تقول لعمّتها زينب بأنّ أخاها قد استُشهد توّا وهو مخضَّب بدمه.
«ألم ألبس السواد لفقد أخي ؟
كلامكِ يا عمّتاه لن يؤثّرَ في قراري».
زينب تردّ عليها بالقول إنّ الظروف تستوجب العرسَ. إذا كان من المفروض أن تثمر بذرة الإسلام فيجب أن نقيمَ العرسَ هذا. وعندما تواجه فاطمة هذا الدليل تتقبّله، وهي تعلم أنّ عرسها أمرٌ خطيرٌ وحيويّ. وفجأة تشاهد فرساً من دون فارس، إنّه فرسُ أخيها عليّ الأكبر، تصرخُ فاطمة صرخةً مدويّةً بحيث تصل([561]) صرختُها إلى العرش.
تذهب زينب إلى أخيها الحسين وتخبره بموافقةِ فاطمةَ على الزواج. الحسين يخبر أمَّ القاسم بأنّه يجب أن يُقامَ العرسُ فوراً، فتجيبه أمُّ القاسم:
«...أمُّ القاسم : فداكَ يا سيدي.
في هذا الظرف، كيف أُقيمُ عرسَ القاسم؟
هل يجب أن نخضِّبَ يدَ العريس بالدماء؟
وستذهب غرفة العرس كالورد هباءً...».
ولكنَّ الحسين يردّ بالقول:
إمّا مجلس المأتم والحزن، وإما مجلس الفرح والعرس. نعم، سوف يكون.
وتصرخ أمُّ القاسم قائلةً بأنّ عليّاً الأكبر لا زال طريحاً على الأرض، وإنّ أُمَّه حزينةٌ عليه، ومن غير الإنصاف أن يُقامَ العرسُ.
ولكنّ الحسين يأمرها أن تذهب عند أمِّ ليلى، وأن تلحّ عليها بأن يُقامَ العرسُ وأن تقومَ أمُّ ليلى بنفسها بإقامة مقدّمات العرس. تذهب أُمُّ القاسم إلى أمِّ ليلى وتراها تنثر التِبنَ على رأسها، وتنوح وتبكي على ولدها عليّ الأكبر. تطلب أمُّ القاسم من أمِّ ليلى أن تكفّ عن العزاء. عندها تهنّيءُ أمَّ القاسم بالعرس.
تطلب أمُّ القاسم من أمِّ ليلى أن تصبغ يدها بالحنّاء، وأن تخرج لباس العزاء وتقول لها بأنّ العزاء لن يغيّر من الأمر شيئاً. يبعث الإمام الحسين أخته زينب عند أمِّ ليلى لتكفَّ عن البكاء والعويل، وأن تقبل ما تريده منها أمُّ القاسم.
بعدها يطلب الحسين من أخته زينب، أن تجهِّز غرفةً للعريس قاسم، ولكنّ أمَّ القاسم تبدأ بالنحيب والبكاء. يأتون بملابس عرس عليّ الأكبر، ويلبسون العريس القاسمَ، عندها يقول الحسين لزينب أن تقوم بوضع الحنّاء بيد العَريسين. والآن أصبح كلّ شيء جاهزاً لإقامة الزفاف.
زينب تحمل معها الحنّاء والحلوى وماء الورد والحليّ؛ لتقدّمها إلى فاطمة، وتقول لها: البسي ملابس العرس، وتقدّم لها التهاني بالعرس، عندها تقوم زينب بوضع الحنّاء بيد فاطمة، وفي الوقت نفسه تقوم أمُّ القاسم بوضع الحنّاء بيد ابنها القاسم.
تطلب زينب من فاطمة ـ بناءً على أمر الحسين، وبحسب عادة الإيرانيّين القدماء ـ أن تركب العروس فرس عليِّ الأكبر (العقاب)؛ لكي يوصلها إلى غرفة العريس.
تمتنع فاطمة من ركوب الفرس، وتقول لعمّتها زينب أن تأخذها إلى أبيها؛ لكي تقول له إنّها لا يمكنها أن تركب فرس أخيها الشهيد عليٍّ الأكبر. تربتُ زينب على ظهر الفرس وتتذكّر ابن أخيها عليّاً الأكبر، ثمّ تنقل كلّ ما جرى للحسين. الحسين يحزن كثيراً. إنّه حزين على استشهاد عليٍّ الأكبر، ويتذكّر صوته وعيونه وقامته وضفائره. يدعو زينب ويقول لها بأنّ فاطمة على حقٍّ. يطلب الحسين أن يذهبوا بفرسه (ذو الجناح)؛ لينقلوا فاطمة إلى غرفة العريس، فالفرس مغطّى بالسواد. تتمنّى فاطمة وهي تمتطي الفرس (ذو الجناح) لو كانوا ينقلونها إلى القبر بدلاً من غرفة العريس.
الجميع يتمنّى للقاسم حياة سعيدة، ويلتحق باحتفال العرس، حتى إنّ الإمام الحسين يقدّم هدايا العرس المكوّنة من قطع الحلوى إلى أعدائه، شمر وعمر بن سعد.
يغادر العريس والعروس المكان للدخول إلى غرفة العرس. فاطمة تنوح قائلة بأنّ مراسم العرس ترافقها عادة الضرب على الدّفّ والرباب ولكنَّ عرسها تتخلّله طبول الحرب. تمرُّ دقائق حيث يغادر العريس قاسم المكان بعد أن عرف مصيره الذي ينتظره هو وعروسه، ولكنَّ فاطمةَ تبكي وتقول:
«... فداك نفسي، هل هذه عادة أهل الوفاء؟
تعالَ، وأجلس ليس الوقت وقت الفراق».
يدور الحديث حول يوم القيامة، تطلب العروس من عريسها أن يعطيها علامة يمكن أن تجعلها تعرفه يوم القيامة في الصحراء الذي يُحشَرُ الناس فيها؛ يقول قاسم لها: إنّه سيُحشَرُ يوم القيامة وقد شُقَّ ثوبُه وتَقطَّعَ جسدُهُ إلى مائة قطعة، وعيونه باكية، وهو سيكون ضيفاً عند أبيها (الحسين).
أمّا أمُّ القاسم، فقد احدودب ظهرُها، تبدو مضطربة جدّاً بعد علمها بقرب موت ابنها. إنّها تطلب من ابنها أن يغفر لها إذا ما قصّرت في تربيته، إنّها تصفه بشبل الأسد، وتقول بأنّ لبنها حلال عليه.
يسأل عبد الله الابن الأصغر للإمام الحسن أخاه القاسم ويبدو باكياً: «ماذا أفعل بعدك يا أخي العزيز؟». ويردّ القاسم عليه ويقول: أسلّمك الآن إلى عمتي زينب، ويوجّه القاسم خطابه إلى عمّته زينب ويضع يد أخيه عبد الله وأمّه بيدها. بعدها يقول للإمام الحسين إنّه مستعد لخوض القتال. يضع الحسين كفناً على لباس عرس القاسم، وبذلك يأذن له بخوض القتال وهو ما كان يتمنّاه منذ زمن.
يعود القاسم إلى عروسه، ليودّعها في آخر اللحظات، فكم تكون لحظة الوداع الأخيرة صعبة على فاطمة! القاسم يقدّم آخر توصياته لأمّه بشأن اهتمامها بعروسه، بعدها يغادر المكان. يدعو الحسين للقاسم، ويطلب من أنصاره أن يقولوا آمين في آخر الدعاء وهم يفعلون. فالقاسم في غاية الشجاعة والإقدام من أجل خوض القتال. وها هو القاسم يخوض القتال بكلّ شجاعة. عندها يحين موعد اللحظة الأخيرة، ويسقط القاسم عن فرسه مضرّجاً بدمه من دون أن يكون له ناصر ومعين.
يسلّ الشمر سيفه ويقف فوق رأس القاسم ليحزّ رأسه، يطلب القاسم من الشمر أن يمهله لحظات ليرى وجه عروسه للمرة الأخيرة. ولكنّ الشمر يرفض طلبه، ويوجّه كلامه لعمر بن سعد طالباً منه الإذن ليحزّ رأس القاسم.
يقول عمر بن سعد: «يا معين أمهله ساعة»! ويبدأ بتوجيه الأسئلة إلى القاسم الذي يحتضر، وفي هذه الأثناء، إذ يهمّ الشمر لكي ينهي حياة القاسم، هنا يصرخ القاسم ويطلب العون من الإمام الحسين×، والحسين يتوجّه صوب القاسم بعد أن يشقّ بحراً من الكفار، يضع رأس القاسم في حضنه ويلعن قاتليه. وفي النهاية ينزل الشمر ضربته الأخيرة. يرجو القاسم من الحسين أن لا يأخذه بهذه الصورة إلى المخيّم أي بجسده المجروح والمخضّب بالدماء، هو يخجل من عروسه أن تراه على هذه الحالة، ولكن القاسم يغمض عينيه ويفارق الحياة.
يعود الحسين× إلى المخيّم، ويعلن استشهاد القاسم، ويطلب من زينب، أن تُلبس فاطمة السواد، وأن تذهب إلى أمّ القاسم وتعتذر منها من جانبه.
الحسين في هذه التعزية، كما في التعازي الأخرى، محور جميع الأحداث. فكلّ شيء يدور حول قرارات الحسين، وأفكاره وأمنياته وكلامه. تارة نراه ينوح لوحده في الصحراء الحارّة على وجوده وحيداً، ويشكو إلى جدّه النبي محمّد| من أصحابه الذين تركوه وحيداً خوفاً على حياتهم: «يا جدّي، أشكو إليك أمّتي وأشكو إليك غربتي».
يشعر الحسين بأنّه وحيد وغريب، مقابل جيش الأشرار، لقد تركه أصحابه، فلا صاحب له ولا معين، وقد هربوا بعد أن وضعوه في مواجهة الأمواج العاتية والحوادث المزرية. فالحسين ظل وحيداً، غريباً لا أحد يعينه في إنقاذ أهل بيته من النساء والأطفال وإخراجهم من الخيام. فكثير من مقاتليه إمّا تركوه أو استُشهدوا، ليس لديه حيلة ولا من يعينه سوى النساء والأطفال والنواح على وحدته، لأنّه غير قادر على فعل شيء.
في هذه التعزية، يرى الحسين بأنّ كلّ شيء قد ارتبط ببعضه، العقل والواقع والذكاء والعاطفة والوفاء للتقاليد الدينيّة، والشعور بالمسؤوليّة والأكثر من ذلك، القتال المؤلم والكبير الذي غطى بظلاله ساحة القتال وقد أثرت الأحداث الماضية على روحه لا سيّما فقده للأحباب والأصدقاء الأوفياء. فالحسين× يقف في ساحة القتال وهو في منصب الإمام، ومرّة يقف كأب فقد عزيزه، ومرّة يقف وحيداً من دون معين في ساحة الوغى، ومرّة يقف كإنسان كبير، منتصر ومظفّر وتارة يقف كإنسان عادي فقد ملاذه.
ففي اللحظة التي يمتنع الحسين× عن إعطاء الإذن للقاسم من أجل خوض القتال، كان يشعر بأنّ أخاه الحسن حيّ وموجود. فالحسين لا يسمح لنفسه أن يرسل ابن أخيه إلى ساحة القتال؛ لأنّه يعلم النهاية الحزينة التي تنتظره. الإمام الحسن لم يخض الحرب والمواجهة مع بني أميّة، وقد أوصى أن يُزَفَّ القاسم، ولهذا السبب فإنّ الإمام الحسين سمح بزواجه من ابنته. على أمل أن يحفظ هذا الزواج الترابط الدمويّ والقتاليّ، وأن يقيم علاقة جديدة مع القاسم. هذه العلاقة الجديدة والمباركة التي تكون في الوقت نفسه محكومة بالفشل.
فاللحظات التي تنتهي بالمصائب هي اللحظات التي يصدر فيها الإمام الحسين أمراً بأن يلبس القاسم ثياب عرس عليّ الأكبر الذي استُشهد قبل لحظات، وفي الوقت الذي يأمر ابنته فاطمة أن تركب فرس عليّ الأكبر، وكأنّ الحسين مثله مثل جميع الآباء المفجوعين الذين لا زالوا مصمّمین، ويحدوهم الأمل مثل أيّ مسلم حقيقيّ يحبُّ أن يرى ابنه الذي فقده في اللحظات الحرجة التي يواجه فيها عدوّاً شقيّاً وعنيداً يقف أمامه، ربّما لا يريد الحسين أن يقبل الواقع أو لا يتمكّن من القبول بأنه فقد ابنه. وربّما أراد بهذه الأفكار والأعمال أن ينفي وجود أيِّ فرق أو تمييز بين عليّ الأكبر والقاسم وفاطمة. وأن يقيم جسراً بين ساحة القتال والموت، والعرس وارتباط العرس وهكذا، وعن طريق الوضع الناجم أراد أن يجعل صورة وذكرى عليّ الأكبر على أفضل وأكمل وجه. فأمره بإقامة العرس. واستخدام لباس وفرس عليّ الأكبر (العقاب) يشير إلى إنسانيّة الإمام الحسين في دوره كأب فقد ابنه الشجاع قبل أن يشهد عرسه.
إنّ امتناع فاطمة من الاستجابة لأمر أبيها بركوب فرس عليّ الأكبر يظهر الروح الإنسانيّة والعاطفيّة للمرأة الشرقيّة، والحسين يقبل ذلك بكلّ قوّة رغم ألمه وحزنه، وهو يتعاطف مع ابنته (فاطمة)، يشاطرها حزنها. إنّ قلب الحسين مليء بالحزن على فقد ابنه عليّ الأكبر وهو يبكيه. الحسين حزين في هذه التعزية أكثر من أي تعزية أُخرى، هل هذا الشعور ناجم عن العلاقة العاطفيّة بين ما هو حادث الآن وما حدث في الماضي، وما يجب أن يمرّ على القاسم وعليه؟.
الحزن يخيّم على هذه التعزية: الحزن وأيضاً البكاء. فإذا ما لاح ضياء من الوجه المضيء فإنّ ذلك ناجم عن الحزن واليأس، بل يدلّ على الأمل الطويل والعمر القصير، فهذا الضياء قصير، ويمرّ مرّ الكرام، ويدعو إلى الضحك والفرح وهذه التعزية تبدو مضحكة وكاريكاتيريّة، وتظهر نفسها في صورة محزنة. وكأنّما أفرغوا داخلها وأحاطوا خارجها بالحزن والألم، ومقابل الصيحات والصرخات يجري الحديث عن التهاني والتمنّيات. فلحظات السرور لا يمكن أن تُوجِد السرور والفرح، والتراجيديا تقع، والفرح والسرور يُدفَن تحت أكوام المصائب. الموت يضحك بوجه مكفهرّ. فالمتوقّع أن يُراق دمٌ. فالظلم يُسقط العظمة والكبرياء. لا يمكن لأحد أن يقول متى وأين وكيف يمكن أن ينتهي الوضع؟.
مع أنّ الحديث ينبئ عن الوصل والارتباط، لكن لم يتمّ أيُّ ارتباط للزوجيّة، فالحديث يجري عن الحرب والظلم الذي يقع في نهاية المطاف. ألا يكون هذا من أكثر أغاني الحبّ ألما؟ شاب وشابة محبّان وعاشقان يملأ قلبهما الحبُّ، أحدهما يركب الموت والآخر يبقى وحيداً بلا ناصر، يواجهان مصيراً ظالماً، فعقد ارتباط شابة وشاب محبّ، ينفذ في بحر من الدماء، عقد يكون نهايته البعد وخاتمته الفراق الأبديّ.
على الرغم من أنّ القاسم شابٌ وقليل التجربة، لكنّه يدرك أنّه سيموت، ويرضخ لمصيره بكلّ رجولة وكبرياء، لا يشكو ولا يتذمّر. وعندما تسأله فاطمة كيف يمكن لها أن تعرفه يوم القيامة يجيب:
«... تتعرفين عليّ يومَ القيامة،
وأنا ممزَّقُ الثياب، وحزينُ العين،
وستواجهين أبداناً مقطَّعة مائة قطعة
وسنقفُ مع الشهيدين الأكبر والعبّاس
في خدمة أبيكِ العطشان».
فاطمة ترى لقطة أخرى مروِّعة، عندما تشاهد أباها يُلبس زوجها كفناً، ويحوم الموت حول وجهه وقامته. فهي لا تتحمّل ذلك وتصرخ وتقول لوالدها أن يُنحِّي الكفن عن جسد زوجها. وحيث إنّها ترى بأنّ صراخها اللاإراديّ سيكون كفراً، تطلب من الحسين أن يلبسها الكفن بدلاً من القاسم. فشعورها يتضمّن عدّةَ أحاسيس، الخوف من الموت، والزواج غير المتوّج، والشعور بالذلِّ والهوان مقابل الدين والأب، والتمنّي بحياة زوجيّة هانئة وسعيدة.
يتغير وزن الشعر في حديث الشاب والشابة، عندما تمدح فاطمةُ القاسمَ.
القاسم يقدّم آخر وصاياه لأمِّه حول زوجته. هذه الوصية مفعَمة بالأمل بالمستقبل، مستقبل لا يُعرَف متى وأين وكيف سيحدث. القاسم يعلم بأنّه ذاهب لا محالة، ولا أمل له بالحياة والمستقبل أو الزواج، ولكنّ قلبه لا يزال مفعَماً بحبِّ فاطمة، يريد أن يكون قلبه حتى آخر لحظات الموت متعلّقاً بفاطمة. على أمل أن لا يكون الموت قد أنسى فاطمة ذكره، بل أن يبقى حبّهما خالداً. القاسم ينوي السفر ومع أنّ سفره سيفضي إلى الموت، ولكنّه يأمل أن يعود من السفر سالماً معافى.
عندما يحين وقت الوداع والتوجّه إلى ساحة القتال، يودّع القاسم كلَّ ما يرتبط بحياته، سواء كان علناً أو سرّاً. إنّه يحبُّ الحياة !. ومع أنّه يواجه مستقبلاً مشوباً بالمصائب، مع ذلك لديه أملٌ بالمستقبل، إنّه يودّع أصدقاءه، ويعمُّ صمتٌ لا يكسره سوى ضرب طبول الحرب، وهذا منظر مؤلم حقّاً.
عندما يقرِّر القاسم التوجّه إلى ساحة القتال، يردّد الحسين× الذي يحمل على عاتقه رسالة الأنبياء في كربلاء صرخة (الله أكبر)، هذه صرخة استغاثة وتحذير تدلّ على أهميّة ما حصل وما يحصل توّاً. أي أنّ شابّاً لا تجربة له، ولكنّه مفعَم بالأمل، عريس تلوح على ملامحه علامات النشاط والحركة، مؤمن، محبّ متوجّه إلى ساحة القتال، لربّما يأمل الحسين× بهذه الكلمات أن يدرك أصحابه ما يواجهون في الحال والمستقبل، إنّ صرخة: الله اكبر هي دعوة للصلاة، صرخة ضدّ الظلم الذي عمّ تلك الأرض، فصلاة الحسين دعاء يرافق الذين معه في سفره، سفر مليء بالحبّ والوفاء والإيثار.
في الواقع تُظهر شجاعةُ القاسم× ـ في ساحة الوغى ومواجهته قادة الأعداء، منهم الشمر وعمر بن سعد ـ حقيقةَ هذا الشاب المكلوم، إنّنا نرى القاسم في قمّة الإنسانيّة، ومفعم بالأمل والعظمة، إنّه لا يمكنه وحده أن يحقّق نصراً مقابل هجوم الأعداء والأشقياء المتعطّشين للألقاب والمناصب والنياشين، وقد انخرطوا في جيش العدوّ من أجل الحصول على مغانم ماديّة، فالقاسم لا يمكنه أن يحقّق نصراً، إنّه يسقط على الأرض شهيداً، فالمصيبة تظهر وجهها الدمويّ القبيح والعنيف والكريه الذي لا يرحم.
لم يكن الشمر يأبه بما يحمله الشاب من أمل، وهو يراه متعلّقاً بعروسه، ولكن على الرغم من تعاطف عمر بن سعد مع الشاب إلّا أنّ الحقّ يظهر روح هذا الشاب الطاهر، فالحديث الذي يجري بين القاسم وعمر بن سعد يظهر الآمال والمخاوف والأحزان التي تواجه الزمن الضائع. فعمر بن سعد على الرغم من إظهاره التعاطف مع القاسم، إلّا أنه يتجاهل الأمر، ويلتزم الصمت عندما يرى الحقائق التي جرّت القاسم إلى ساحة القتال. إنّه يعرف أنّ القاسم هو ابن الإمام الحسن وصهر الإمام الحسين، ويعلم أنّه عريس ويعلم أيضاً أنّ الحقَّ مع القاسم والحسين. ولكنّه على الرغم من ذلك يتجاهل الأمر. وكانت أجوبة القاسم عن أسئلة عمر بن سعد صريحة، وتنمّ عن حبِّ القاسم للإسلام ولعروسه:
عمر بن سعد: هل كان لك لقاءٌ مع عروسِك؟
القاسم: لقد نظرتُ إلى وجهها بتمعّن.
عمر بن سعد: هل استمعتَ إلى كلام عروسِك؟
القاسم: نعم، لقد قلتُ لعروسى كلمةَ الوداع.
رُبَّما تكون قصّة حبِّ القاسم وفاطمة من أكثر قصص الحبّ الحزينة التي لم تتكلّل بالنجاح. هذه القصّة المتخيَّلة قصّة الزواج اللامعقول تعكس وضعاً تراجيديّاً مؤثّراً، وكان لها انعكاس في أكبر تراجيديا العالم قاطبة. فكلّما تظهر ملامح القصّة تزداد انعكاساتها على مصير القاسم. فالذين يقومون بدور القاسم يوظّفون مشاعر المشاهدين من أجل إظهار الروح العميقة خلال عرض قصّة الحبِّ غير الناجحة. فنرى خلال العرض المسرحيّ التعبير على أكمل وجه، عن غرور الإنسان وإخلاصه، والمشاهد يجد نفسه غارقاً في مشاهدة كلّ جزء من القصّة.
فالجزء الأكثر إثارة في المصيبة هو عندما يحتضر القاسم، فالحسين يقف في آخر اللحظات من حياة القاسم إلى جانبه، وهو غارق في دمه. يضع رأسه في حجره، فيرجو القاسمُ الحسينَ أن لا يأخذه عند فاطمة وهو مضرّج بدمه، ووجهه مغطّى بالدماء. فهذا الرجاء يظهر نظرة القاسم إلى الحبّ والهزيمة والقلق من الموت.
إنّ أحد الجوانب المثيرة للإنتباه لهذه التراجيديا التي تُقام على المسرح الإيرانيّ، استخدام التقاليد الإيرانيّة الأصيلة، فاستخدام التقاليد ملائم للأحداث والوقائع والحوار في كلّ لقطة. في كثير من الحالات تُستخدَم الثقافة الشعبيّة العامّة في القصص حيث تزيد من جاذبيّة العرض.
اختيار اسم (العقاب) لفرس علي الأكبر، ووضع الحنّاء في أيدي وأرجل ورأس العريس والعروس، وتزيين غرفة العروس، ونقل العروس وهي تركب ظهر الفرس، وتقديم هدايا من زعماء القبائل إلى العريس، وإعداد مراسم العرس وتوزيع الحلوى ودعوة العدو للمشاركة في احتفالات العرس، ولبس السواد على الميِّت، كلّها لها جذور إيرانيّة قديمة. كما أنّ لبس الملابس الملوّنة بعد انتهاء مراسم الحداد يذكّرنا بالتقاليد والأعراف الإيرانيّة.
إنّ استخدام الأعراف والتقاليد الإيرانيّة القديمة، وربطها بالتعزية، يوجد ترابطاً قويّاً بين الناس ورجال الدين، ويجعل المشاهد مشاركاً في الأحزان والأفراح كافّة. ومن بين هذه التقاليد التي يمكن الإشارة إليها هنا ما يطلبه الشخص من الآخرين قبل موته، أن يسامحوه ويصفحوا عنه، وكذلك وصيّة الإنسان قبل حلول أجله.
إنّ استخدام لقب شاهزاده (الأمير) لأولاد الأئمّة ولا سيّما أولاد الإمام الحسن والإمام الحسين÷ يجذب المشاهد. ويُطلَق على أولاد الملوك في إيران لقب شاهزاده، ولا يُطلَق على أولاد الخلفاء مطلقاً. فعندما يستخدم الرواديد (المنشدون) هذه الألقاب في التعزية فإنّهم يقيمون ارتباطاً بين أبطال كربلاء والشخصيّات الإيرانيّة الأسطوريّة، علماً بأنَّ إحدى زوجات الإمام الحسين كانت إيرانيّة، وهي بنت يزدجرد آخر ملوك الساسانيّين في إيران.
في هذه التعزية تُعرَض تضحيات النساء، فالنساء يضعنَ حاجاتِهنَّ وميولهنَّ الطبيعيّة ومشاعر الأمومة جانباً، ويدعمنَ الحسينَ، وهذا مظهر من مظاهر الصدق والتقوى من أجل تنفيذ أوامر الله وإعلاء كلمته. فالنساء يتجاهلنَ ميولهنّ الكبيرة والصغيرة ورغباتهنّ الشخصيّة، وهنَّ يحسبنَ موت أزواجهنّ وأولادهنّ وإخوانهنّ بعزٍّ خيراً من الموت بذلّ. فأمّ القاسم تطلب إلى الحسين بكلّ حرارة إعطاء الإذن لابنها للمشاركة في القتال. وفاطمة الحزينة على أخيها عليّ الأكبر ـ ترضخ لطلب أبيها ـ تبعث زوجها لخوض القتال، وزينب التي تُعدّ أنموذجاً للتربية الإسلاميّة تتجاهل مشاعرها. وعندما يعزم القاسم على التوجّه إلى ساحة القتال، تقول له اُمُّه:
«يا شبلي، لَبَنِي حلالٌ عليك،
يا بنيّ، هنيئاً لك، ألف مرّة».
وعندما يبتعد القاسم عن أمّه، تصيح مودِّعة إيّاه:
«اذهبْ يا روحي، اللهُ يكونُ في عونك
وليكنْ دعاءُ أحبائكَ زاد َطريقك».
ويكون وداع القاسم لأمّه وداعاً مؤثِّراً، حيث يقول حولَ مصير زوجته:
«إذا سقطتُ من على فرسي
وجاء الحسينُ بنعشي وهو حزين
وإذا رأتْ زوجتي نعشي وأنا جريح
فسوف تلطِّخُ يدَها ورجلَها بدمي خضابا
فلا تسمحي لها أن تبكي وتندبَ عليّ
ولا تنثرْ شعرَها انزعاجاً
فعروسي تعيسة الطالع
وهي أمانةٌ بيدك، يا أُميّ
أنتم أمانةٌ بيد الله
فإذا قُتلتُ، أطلبُ منكم السماحَ والعفوَ».
عندما تودّعُ الأمُّ ابنَها، فهي ليست على اطلاع بالمستقبل. والنساءُ الوفيّات اللاتي يتجاهلنَ رغباتهنّ وآمالهنّ، يمكنهنّ الوصول إلى أهداف الحسين× العليا.
يعترف الأشرار بأحقيّة الإمام الحسين. وها هو شمر بن ذي الجوشن يعترف بحقّ الحسين في القتال الدائر بين الحقّ والباطل، ويقول:
«... هل من مبارزٍ، يا جوهرةَ السخاءِ ومعدنَه
هل من مبارز، يا ملكاً وحيداً لا قريباً ينصره
هل من مبارز، يا من يمثّل سورة والليل والضحى...».
ألا يكون الشمر قد اعترف بأحقيّة الإمام الحسين عندما قال الأبيات السابقة؟ ألم يقبل عمر بن سعد بعظمة ومكانة القاسم وعليّ الأكبر عندما يقول: هل من مبارز يا خليفة الأسد النشط؟ فعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن من أجل إظهار أحقيّة الحسين، يقتربان من المشاهدين، وهذا ما يقرّب المشاهدين إلى روح العرض. الحوار يكون في خدمة الواقع، يجب قول الحقيقة حتّى إذا كان القائل في لباس الخصم. وحيث إنّ المشاهدين غارقون في عالم الخيال فإنّهم لا يتصوّرون أبداً بأنّ الأشقياء لا دين لهم. فالأشقياء حتّى يدّعون بأنّهم يعشقون الحسين ويعدّونه واحداً منهم، وهم يذرفون الدموع على مصيره ومصير أصحابه. فالحقيقة عندما تخرج من فم العدو تمنحها قوّة ومصداقيّة كبيرة. يحاول الممثّلون الذين يؤدّون الأدوار إبعاد الأشقياء من كلّ ما هو قبيح، ولا يسمحون بأن تظهر على وجوههم ملامحُ الإلحاد والكفر.
تتوالى المشاهد بسرعة لا تتيح للمشاهد أن يتنبّأ بالمشهد القادم. فالأحداث التي تقع في التعزية لا يمكن للمشاهد أن يتنبّأ بها كاملة، مع أنّ الأحداث مقدّرة مسبقاً، وعلينا أن نقبل هذه الحقيقة بأنّ الأبطال مستعدّون للتضحية بأرواحهم. فعندما يستخدمون كلمات نابية ومهينة، فإنّهم يستخدمون مفاهيم دينيّة تختلف كثيراً عن المفاهيم السطحيّة الدنيويّة التي تستلزم نظرة قريبة إلى الكناية والإهانة. فالحسين وأصحابه يستخدمون العبارات؛ لسبب أنّهم على حقٍّ، ولكنَّ القاسم والآخرين لا يلعنون العدوَّ. إنّهم لا يقولون أكثر ممّا يقوله الأعداء. إنّهم يقولون عبارات وكلمات يؤمنون بها مثل: قوم ملعونون، وظالمون ولا حياء لهم.
ومع أنَّ الأحداث والصور التي تبرز في الواقعة تضفي على الحدث جانباً خياليّاً، ويأخذ التمثيل والحوار حالة كاريكاتوريّة، أي عندما ينوح الحسين بعد موت عليّ الاكبر، ويقول سأقبّل سرج فرسه، فهذا ما يظهر الحبّ الكبير الذي يكنّه الأب لولده، ولكن يجب الانتباه إلى أنّ رواة التعزية والكتّاب والممثّلين لم يكونوا محترفين، بل كانوا من بين الناس العاديّين، الذي كانوا يظهرون إيمانهم ووفاءهم في الحادث الدينيّ. وهذا كلّه يؤثِّر على المشاهد، لا سيّما قراءة الشعر في بحور متنوّعة واستخدام الطبلة، والأدوات الموسيقيّة، والفرس ورموز أخرى، تجعل المشاهد يظهر ردَّ فعل عاطفيّا. فعروض التعزية لا تهدف سوى إلى تقوية إيمان الناس عن طريق عرض الوقائع الدينيّة، بشكل يجذب المشاهدين ويحظى بقبولهم([562]).
خلال دراستنا للعزاء الحسيني عند العرب والفرس تناولنا العزاء في إيران والعراق وبقية البلدان العربية، من القرن الأوّل وحتى وقتنا الحاضر. وميّزنا بين مجالس العزاء التي أُقيمت في التكايا والحسينيّات والمساجد، ومواكب العزاء التي كانت ولا تزال تخرج في شهري محرّم وصفر إلى الشوارع والميادين؛ لإحياء ذكرى استشهاد الحسين، ومنها مواكب اللطم والزنجيل والتطبير وعروض التعزية، التي تُقام في إيران منذ القرن العاشر الهجري.
والسؤال الذي طرحناه في بداية هذه الدراسة هو: متي بدأ العزاء الحسيني أوّلاً في العراق أم في إيران؟ ومتى تحوّل العزاء من إقامة النياحة واللطم والبكاء وقراءة أشعار الرثاء إلى الشبيه والتمثيل على المسرح؟ وبماذا يمتاز مسرح التعزية عند الإيرانيّين عن الشعوب الأخرى؟ وكانت نتيجة ما توصلنا اليه هو أنَّ العزاء الحسيني بدأ في العراق، ومنه انتقل إلى إيران والبلدان العربيّة والإسلاميّة الأخرى.
وخلال دراستنا للعزاء الحسيني في العراق تناولنا وضع الشيعة السياسيّ، وما تحمّلوه من ظلم وقمع من الأمويّين والعبّاسيّين؛ نتيجة حبِّهم لأهل البيت، ومداومتهم على زيارة مرقد الإمام الحسين×، وأشرنا إلى أنّ البويهيّين هم أوّل من أمر بإقامة العزاء علناً في بغداد، وقد نتج عن تشجيع الشيعة لإقامة طقوس العزاء ظهور طبقة من النائحين في القرن الثالث والقرون التالية، وما يُسمَّى بالمناقبيّين الذين كانوا يقرأون مدائح لأهل البيت، وظهر مقابل ذلك الفضائليّون الذين كانوا يمدحون الخلفاء .
كما درسنا العزاء الحسيني في العراق في العصور التالية وفي العصر الحديث، وذكرنا مواقف العلماء من خروج مواكب العزاء والشَّبيه واختلافهم في ذلك، ونتيجة لذلك ألّف العديد من العلماء كتباً، بيّنوا فيها رأيهم في طقوس العزاء، ومنهم من أيّد هذه الطقوس، ومنهم من حرّمها ونهى عنها.
وتناولنا بالدرس العزاء الحسيني في إيران بعد دخول الإسلام إلى إيران وانتشار التشيّع، واتخاذ الصفويّين المذهب الشيعيّ مذهباً رسميّاً للدولة الصفويّة، وتشجيعهم للشعراء في مدح أهل البيت، ورفضهم مدح الملوك والامراء، وتناولنا التعزية في العصرين الصفويّ والقاجاريّ، وظهور الشَّبيه وتمثيل واقعة كربلاء، ودرسنا التفاعل الوجدانيّ بين العرب والفرس في إقامة طقوس التعزية.
كما درسنا بالتفصيل مسرح التعزية في إيران، وبناء التكايا لاقامة عروض العزاء، وأجرينا دراسة مقارنة لثلاث مسرحيّات عاشورائيّة، وتناولنا تعزية عرس القاسم بعد الاشارة إلى الجدل الدائر بين الكتّاب حول حقيقة هذا العرس، فمنهم من ينفي حصول ذلك، ومنهم من يشدّد على حصوله يوم العاشر من محرّم.
وخلال دراستنا لمسرح التعزية رأينا أنّ طبقة من الفنّانين المسرحيّين ظهروا في إيران، ومثّلوا واقعة عاشوراء على المسرح، كما ظهر رسّامون رسموا لوحاتهم المستوحاة من ساحات القتال في كربلاء، ووجوه الأئمّة والأنبياء، وكانت هذه اللوحات تُعرض في مجالس التعزية، ويقوم أشخاص حفظوا الروايات والأخبار المرتبطة بواقعة كربلاء بشرح الأحداث، نقلاً من كتاب بالفارسيّة ألّفه أحد الخطباء في القرن العاشر الهجريّ، وهو الملا حسين واعظ كاشفي بعنوان (روضة الشهداء). كان الرسّامون يتخذون من المقاهي مقراً لرسم لوحاتهم على القماش، والستائر والخشب والزجاج، وعرضها على روّاد المقاهي أو المشاركين في مجالس التعزية، وأُطلِق على هذه الرسوم اسم (رسوم المقاهي)، وكانت حتى وقت قريب تُعرَض في عاشوراء. إلّا أنّ رسم هذه اللوحات توقّف بسبب وفاة الرسّامين الكبار، وعدم مواصلة الرسّامين الذين جاؤوا بعدهم لمثل هذا النوع من الرسم.
إنّ ما لاحظناه خلال دراستنا لمسرح التعزية في إيران أنّ هذا المسرح انتشر بصورة سريعة في إيران، ولا يزال يحظى بالاهتمام، وقد اعترف العديد من المسرحيّين العالميّين بذلك، بينما لم نجد نشأة مسرح التعزية في العراق على الرغم من وقوع أحداث كربلاء، ومحاولات حثيثة لوضع أسس مسرح التعزية في هذا البلد.
كان العراقيّون من الموالين لأهل البيت يتخذون مراسم العزاء على الحسين فرصة للإعراب عن معارضتهم للسلطات الحاكمة، وتحدّيهم للأنظمة وذلك عندما كانت الحكومات العراقيّة تنتهج سياسة معادية لهم.
ولم نجد السلوك نفسه عند الإيرانيّين خلال الاحتفال بمراسم عاشوراء، بل إنّ المراسم التي كانت تقام في المدن الإيرانيّة كانت تعبّر عن الحزن والأسى؛ لما لاقاه الحسين وأصحابه وأهل بيته من ظلم وجور على أيدي حكّام بني أميّة، ولم ترافقها شعارات سياسيّة. ولم يخلُ تاريخ إيران من حكّام اضطهدوا الشيعة، ومنعوهم من إقامة العزاء على الحسين، فقد اتخذ العديد من الحكّام الذين حكموا إيران في القرون الأولى من الهجرة مواقف معادية من الشيعة، ولم يسمحوا لهم بإقامة مراسم العزاء. وكان الشيعة يقيمون العزاء خفية في البيوت.
یجد القاریء خلال قراءته المواضیع المدرَجه فی الباب الاول من الأطروحة موضوعاً جدیداً تفرّدت هذه الأطروحة بجلائه، ولم یکتب أحد عنه فی الماضی أَلا وهو العزاء الحسيني فی إيران من العهدین الصفوی والقاجاری، والعهود التالیة وخاصة ما رواه السیّاح الغربیون عند زیارتهم لإيران عن مواکب العزاء التی کانت تطوف الشوارع، ومجالس العزاء التی کانت تُقام فی البیوت، وعروض التعزیة التی کانت تُقام علی المسرح.
وفی هذا الباب یطالع القارئ أيضاً موضوعاً جديداً لم أُسبق إليه، وهو ظهور طبقة من الخطباء، و الشعراء والرواديد، والرسامين في إيران الذين عملوا على ترسيخ العزاء الحسيني عند الإيرانيين، كما أنَّني استطعت تخصيص موضوع جديد حول الأفلام الوثائقية التي أُنتجت في إيران، وتناولت واقعة كربلاء ومنها: فيلم: تعزية أسد الله في نطنز، وفيلم مجلس تعزية خروج المختار، وفيلم السفير، وفيلم يوم الواقعة، وفيلم القائد الوحيد، وفيلم ولاية العشق.
وفي الفصل الثالث من الباب الأول يجد القاري موضوعاً جديداً، وهو التأثير المتبادَل بين العراقيين والإيرانيين في إقامة مراسم العزاء، وخاصة التشابه الكبير في طقوس العزاء في العراق وإيران، ومنها مجالس العزاء، ومواكب العزاء، وحمل المشاعل، وركضة طويريج وحرق الخيام، وعرس القاسم، ومهد علي الأصغر والفرس ذو الجناح، وشبيه الأسرى وشبيه علي الأكبر، وشبيه مسلم بن عقيل وطفلي مسلم بن عقيل، وحمل التوابيت، وحمل صور الائمة، والسير على الأقدام.
علماً بأنَّه في العصر الصفويّ اعتاد الإيرانيّون على زيارة مرقد الإمام علي بن موسى الرضا× في مدينة مشهد (شمال شرقيّ إيران) مشياً على الأقدام؛ تأسّياً بملوك الصفويّين، ومنهم الشاه عبّاس الصفويّ (الأوّل) الذي كان يذهب من مدينة إصفهان إلى مدينة مشهد، مشياً على الأقدام مثلما كان يفعل جدّه الشاه إسماعيل الأوّل. فقد قطع الشاه عبّاس المسافة بين إصفهان وخراسان مشياً على الأقدام في ثمانية وعشرين يوماً وذلك في العام 1010هـ/1602م.
ومن مظاهر الجِدَّة في هذه الاطروحة موضوع مسرح التعزية في إيران، كيف بدأت عروض التعزية؟ و متى بُنيت أوّلُ تكية في إيران؟ وكيف يُستخدَم الديكور والملابس والموسيقى في مسرح التعزية؟ كما يرى القاري ء دراسة مقارنة بين ثلاث مسرحيات عاشورائية، وإلقاء نظرة علي مسرحية تعزية عرس القاسم التي تُقام في إيران.
* القرآن الكريم
(أ)
* ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، (20 مجلّداً) منشورات دار إحياء الكتب العربيّة، القاهرة، ط2، 1385هـ/ 1965م.
* ابن الأثير، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمّد الجزري (555 ـ 630هـ)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تحقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1418هـ/ 1997م.
* ابن الأثير، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمّد الجزري (555 ـ 630هـ)، الكامل في التاريخ (11 مجلّداً) تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلميّة، ط1، 1407هـ/ 1987م.
* ابن الأعثم، أبو محمّد أحمد الكوفي، الفتوح، تحقيق: علي شيري، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1.
* ابن بطوطة، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد بن إبراهيم اللواتي، رحلة ابن بطوطة، تحفة النظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، منشورات دار إحياء العلوم – بيروت، 1407هـ/ 1987م.
* ابن تيمية، تقي الدين (661 ـ 728هـ)، الفتاوى الكبرى (6 مجلّدات)، تحقيق وتعليق وتقديم: محمّد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1408هـ/1887م.
* ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفّى 597هـ)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دراسة وتحقيق: محمّد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1412هـ/1992م.
* ابن خلّكان، أبو العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي بكر (608 ـ 681هـ)، وَفَيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (8 مجلّدات)، حقّقه الدكتور إحسان عبّاس، منشورات الشريف الرضي، قم، ط2، 1364هـ.ش [1985م].
* ابن شهر أشوب، أبو عبد الله محمّد بن علي ابن شهر آشوب السَرَوي المازندرانيّ (488 ـ 588هـ)، مناقب آل أبي طالب، مؤسّسة العلامة، قم، 1379هـ.
* ابن عبد البرّ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمّد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1412هـ/ 1992م.
* ابن عساكر، الإمام محمّد بن مكرم المعروف بابن منظور (630 ـ 711هـ)، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق: رومية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمّد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ط: 1، 1404هـ/ 1984م.
* ابن العماد الحنبليّ، المؤرّخ الفقيه الأديب أبو الفلاح عبد الحيّ المتوفّى في العام 1089، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار إحياء التراث العربيّ (6 مجلّدات)، لا تا.
* ابن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي الحسينيّ (المتوفّى 828هـ)، عمدة الطالب في أنساب أبي طالب، منشورات مؤسّسة أنصاريان، قم، ط1، 1417هـ/1996م.
* ابن قتيبة، الدينوري، الإمامة والسياسة، المعروف بتاريخ الخلفاء، مجلّدان، تحقيق الأستاذ علي شيري، دار الأضواء، بيروت.
* ابن قتيبة (213 ـ 276هـ)، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر، جزءان، دار المعارف بمصر، 1966.
* ابن قولويه القمّيّ، أبو القاسم جعفر بن محمّد، كامل الزيارات، تحقيق: علي أكبر الغفاريّ، منشورات صدوق، قم، لاتا.
* ابن كثير الدمشقيّ، أبو الفداء الحافظ (المتوفّى 774هـ)، البداية والنهاية، وثّقه وحقّقه وقابلَ مخطوطاته: الشيخ عادل معوض، الشيخ عبد الله السيد عبد المنعم، محمّد أحمد بركات، الدكتور صلاح الدين خلدية، مركز الشرق الأوسط الثقافيّ، بيروت، ط1، 1428هـ/ 2008م.
* ابن مسكویه، أبو علي الرازيّ، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، حقّقه وقدّم له الدكتور أبو القاسم إمامي، (7 أجزاء) دار سروش للطباعة والنشر، طهران، 1379هـ.ش [2000م].
* ابن منظور، لسان العرب المحيط، دار الجيل، بيروت، ط، 1408هـ /1988م.
* ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1374هـ.ش [1995م].
* ابن نما الحلّيّ، نجم الدين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله، المتوفّى 645هـ، مثير الأحزان، المطبعة الحيدريّة، النجف الأشرف، 1950م.
* أبو الفرج الإصفهانيّ، علي بن الحسين بن محمّد الأمويّ المروانيّ (897 ـ 967م)، مقاتل الطالبيّين، شرح وتحقيق: السيد أحمد صقر، منشورات إسماعيليان، طهران، ط2، سنة 1970م.
(ب)
* الباخرزيّ، علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب (المتوفّى 467هـ)، دمية القصر وعصرة أهل العصر، تحقيق ودراسة الدكتور محمّد التونجي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1414هـ/1993م.
* البخاريّ، صحيح البخاريّ، الإمام الحافظ أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ، المتوفّى في العام 256هـ (5 مجلّدات)، مراجعة وضبط وفهرسة: الشيخ محمّد علي القطب، الشيخ هشام البخاريّ، المكتبة العصريّة، صيدا، لبنان، ط5، 1420هـ/1999م.
* البرقيّ، أحمد بن محمّد بن خالد (المتوفّى 274هـ)، المحاسن، تحقيق وتصحيح وتعليق: السيّد جلال الدين الحسينيّ (المحدّث) دار الكتب الإسلاميّة، طهران، ط1، 1370هـ /1951م.
* البلخيّ، عمرو بن محمود (المتوفّى في العام 559هـ)، مقامات حميدي، منشورات الشركة التعاونيّة للترجمة والنشر الدوليّة، طهران، ط1، 1362هـ.ش [1983م].
* البلاذُريّ، أحمد بن يحيى بن جابر (المتوفّى 279هـ ـ 892م)، أنساب الأشراف (20 مجلّداً)، حقّقه وقدّم له: الأستاذ سهيل زكّار، رياض الزركلي، دار الفكر، بيروت، ط1، 1417هـ/ 1996م.
* البِيرونيّ، أبو الرَّيحان محمّد بن أحمد (973 ـ 1048هـ)، الآثار الباقية من القرون الخالية، الناشر: مكتبة الثقافة الدينيّة، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2008م.
* التستري، نور الله (المتوفّى 1191هـ)، مصائب النواصب، مؤسّسة قائد الغرّ المحجّلين، ط1، 1426هـ.
* التنوخي، القاضي أبو علي المحسن بن علي المتوفّى في العام 384هـ، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجي المحامي، (5 أجزاء)، دار صادر، بيروت، ط1، 1391هـ/1971م.
(ث)
* الثعالبي النيسابوريّ، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل (المتوفّى 429هـ)، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر(3مجلّدات)، حقّقه وفصّله وضبطه وشرحه: محمّد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط2، 1375هـ/1956م.
(ج)
* الجابلقي البروجردي، الحاج السيد علي أصغر، ابن العلّامة الشيخ محمّد شفيع، المتوفّى 1313هـ، طرائف المقال في معرفة طبقة الرجال، (جزءان)، منشورات مكتبة آية الله العظمى مرعشي النجفيّ ـ قم، لا تا.
(ح)
* حاجي خليفة كاتب جلبي، مصطفى بن عبد الله (المتوفّى 1098هـ ـ 1658م)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، (6 مجلّدات) مؤسّسة التاريخ العربيّ، مؤسّسة إحياء التراث العربيّ، مع مقدّمة آية الله العظمى السيّد شهاب الدين النجفيّ المرعشيّ.
* الحرّ العامليّ، أبو جعفر محمّد بن الشيخ الحسن بن علي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق مؤسّسة آل البيت لإحياء العلوم، الناشر مؤسّسة آل البيت لإحياء العلوم قم، إيران، ط2، 1414هـ.
* الحمَويّ الروميّ البغداديّ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، معجم البلدان، منشورات مكتبة الأسديّ، طهران، 1965م.
(خ)
* الخطيب البغداديّ، الحافظ أبو بكر أحمد بن علي (المتوفّى 463هـ)، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، دار الكتب العلميّة، بيروت، لا تا.
* الخوارزميّ، أبو المؤيّد الموفّق بن أحمد المكّيّ (المتوفّى 568هـ)، مقتل الحسين، تحقيق: الشيخ محمّد السماويّ، دار أنوار الهدى، لا تا.
(د)
* الدينوريّ، أبو حنيفة أحمد بن داود (المتوفّى 282هـ)، الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، الدكتور جمال الدين الشيّال، منشورات شريف الرضي، قم.
* الذهبي، الحافظ المؤرّخ شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان المتوفّى في العام 748هـ، تاريخ الإسلام ووَفَيات المشاهير والأعلام، تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري (28 مجلّداً)، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1415هــ/ 1995م؛ الطبعة الثانية، 1413هـ/1993م.
(ر)
* رحلة الرحالة ناصر خسرو، سفرنامه، نقله إلى العربيّة: يحيى الخشّاب، مطبوعات معهد اللغات الشرقيّة، كلّيّة الآداب، جامعة فواد الأوّل، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط1، 1364هـ/1945م.
(ز)
* الزبيري، أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب (156 ـ 236هـ)، نسب قريش، عُني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: إ. ليفي بروفنسال، مراجعة الشيخ أحمد شاكر، وعادل الغضبان، ط3، دار المعارف بمصر.
* الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط 10، 1992م.
(س)
* سبط ابن الجوزي الحنفيّ، يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغداديّ المولود سنة 581هـ، المتوفّى 654هـ، تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمّة، منشورات مكتبة نينوى الحديثة، طهران، لا ط.، لا تا.
* سيد بن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف، منشورات بيام عدالت، طهران، ط 5، 1392هـ/2013م.
* السيوطي، الإمام الحافظ جلال الدين، تاريخ الخلفاء، عُني به ونقّحه وعلّق عليه: محمّد رياض الحلبيّ، دار المعرفة، بيروت، ط4، 1420هـ/ 1999م.
(ش)
* الشدقمي الحمزي الحسينيّ المدنيّ، ضامن بن شدقم بن علي، تحفة لبّ الألباب في ذكر نسب السادة الأنجاب، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ النجفيّ، قم، ط1، 1376هـ/1957م.
(ص)
* الصدوق، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيّ المتوفّى 381هـ، الأمالي، قسم الدراسات الإسلاميّة، مركز الطباعة والنشر في مؤسّسة البعثة، قم، ط1، 1417هـ.
* الصدوق، ابي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيّ المتوفّى في العام 381هـ، الخصال، صحّحه وعلّق عليه علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميّة في قم المقدّسة.
* الصدوق، ابي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفّى في العام 381 هـ، عيون أخبار الرضا، منشورات العلميّه، طهران، لا تا.
* الصدوق، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفّى في العام 381 هـ، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، تحقيق وتقديم: السيد محمّد مهدي السيد حسن الخرسان، مطبعة امير، قم، ط2، 1368هـ.
*الصفدي صلاح الدين الخليل ابن ايبك، الوافي بالوَفَيات، باعتناء: رمضان عبد التواب، دار نشر فرانز شتايز، شتوتغارت، 1411هـ/ 1991م.
(ط)
* الطبراني، الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن ايوب بن مطير اللخميّ الشاميّ الطبرانيّ (260 ـ 360هـ)، مقتل الحسين بن علي بن ابي طالب، حقّقه وعلّق عليه: محمّد شجاع ضيف الله، دار الأوراد للنشر والتوزيع، الكويت 1412هـ.ش [1992م].
* الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير(224 ـ 310هـ)، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار سويدان، بيروت –لبنان.
(غ)
* الغزالي، الإمام أبي حامد محمّد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1426هـ/2005م).
(ف)
* الفاضل الدربندي، أغا بن عابد الشيرواني الحائري (المتوفّى في العام 1285هـ)، إكسير العبادات في أسرار الشهادات (3 مجلدات)، شركة المصطفى للخدمات الثقافيّة، المنامة، البحرين، ط1، 1415هـ/1994م.
* الفتال النيسابوري، الشيخ العلامة زين المحدثين محمّد بن علي، الشهيد في سنة 508هـ من أعلام القرنين الخامس والسادس الهجريّين، روضة الواعظين وبصيرة المتعظين، منشورات الشريف الرضي، قم، ط2، 1375هـ.
(ق)
* القمّيّ: أبو الحسن علي بن إبراهيم، من اعلام القرنين 3و4 هـ، تفسير القمّيّ، صحّحه وعلّق عليه وقدّم له: حجّة الإسلام العلّامة السيد طيب الموسويّ الجزائريّ، منشورات مكتبة الهدى، مطبعة النجف، جزءان، 1387هـ.
* القمّيّ، الشيخ عبّاس (المتوفّى في العام 359هـ)، تحفة الأحباب في نوادر الأصحاب، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، بازار سلطاني، 1370هـ.ش [1991م].
* القمّيّ، عبّاس، (المتوفّى في العام 359هـ)، الكنى والألقاب (3 أجزاء)، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم، ط2، 1429 هـ.ق.
* القمّيّ، الشيخ عبّاس (المتوفّى في العام 359هـ)، نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم، دار المحجّة البيضاء ودار الرسول الأكرم|، بيروت، 1992م.
* القمّيّ، الشيخ عبّاس (المتوفّى في العام 359هـ)، منتهى الآمال، (جزءان)، منشورات الهجرة، قم، ط 8، 1373هـ.ش [1994م].
(ك)
* الكاشانيّ، ملا حبيب الله شريف (1262 ـ 1301هـ)، تذكرة الشهداء (مجلّدان)، تحقيق وتعليق وتهذيب: مؤسسة فرهنگي شمس الضحى، منشورات شمس الضحى، طهران، 1384هـ.ش [2005م].
(م)
* الماوردي، الشيخ أبو الحسن علي بن محمد (المتوفّى في العام 450هـ)، أعلام النبوة، المكتبة الحرّة، لا ط. لا تا.
* المبرّد، أبو العبّاس محمّد بن يزيد (210 ـ 286هـ)، كتاب التعازي والمراثي، حقّقه وقدّم له: محمّد الديباجي، دار صادر، بيروت، ط2، 1412هـ/ 1992م.
* المجلسي، محمّد باقر (المتوفّى في العام 1111هـ)، بحار الأنوار (110 مجلّدات)، منشورات المكتبة الإسلاميّة، طهران، ط3، 1398هـ.
* المسعودي، أبو الحسن علي بن حسين بن علي (283 ـ 345هـ)، مروج الذهب ومعادن الجوهر، نشر دار المعرفة، بيروت.
* المفيد، محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديّ (المتوفّى في العام 413هـ)، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، منشورات مكتب منشورات الثقافة الإسلاميّة)، طهران، ط 10، 1387هـ.ش [2008م].
* المقريزي، الشيخ الإمام تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد، الخطط المقريزيّة، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، منشورات دار إحياء العلوم، ومنشورات مكتبة العرفان، بیروت.
* الموسوي الخراسانيّ الإصبهانيّ، الميرزا محمّد باقر، روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات، جزءان، الدار الإسلاميّة، بيروت، ط1، 1411هـ/1991م.
* الواقدي، محمّد بن عمر بن واقد (المتوفّى في العام 207هـ) المغازي، تحقيق الدكتور رمارسدن جونس، عالم الكتب، بيروت، 1427هـ/2006م.
(ي)
* اليافعي اليمنيّ المكّيّ، الإمام أبو محمّد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان، مرآة الجِنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعدّ من حوادث الزمان، وضع حواشيه: خليل المنصور، منشورات دار الكتب العلميّة، بيروت، 1417هـ/ 1997م.
* الیعقوبيّ، أحمد بن إسحاق، تاريخ اليعقوبيّ، (مجلّدان)، دار صادر، بيروت.
(أ)
* أبو زهرة، محمّد، تاريخ المذاهب الإسلاميّة، دار الفكر العربيّ، القاهرة، ط1، 1996م.
* آل طعمة، سلمان هادي، تراث كربلاء، مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، كربلاء، ط1، 1383هـ/ 1964م.
* أمين، أحمد، ضحى الإسلام، الناشر: المكتبة العصريّة للطباعة والنشر، بيروت، ط1، 2006م.
* الأمين، حسن، دائرة المعارف الإسلاميّة الشيعيّة، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، (26مجلداً4 مستدركات)، ط6، 1422هـ/2001م.
* الأمين، محسن، أعيان الشيعة، حقّقه وأخرجه: حسن الأمين، مطبعة الإنصاف، بيروت، ط1، 1378هـ/1959م.
* الأمين، محسن (1284 ـ 1371هـ)، إقناع اللائم على إقامة المآتم، دار المعارف الإسلاميّة، قم، 1418هـ.
* الأمين، محسن (المتوفّى في العام 1371هـ)، رسالة التنبيه لأعمال الشبيه، مطبعة العرفان، صيدا، ط1، 1347هـ.
* الأمين، محسن (المتوفّى في العام 1371هـ)، المجالس السنيّة في مناقب ومصائب العترة النبويّة، منشورات الشريف الرضي، قم، الطبعة الخامسة، 1394هـ/ 1974م. (ب)
* براون، إدوارد جرانفيل، تاريخ الأدب في إيران، من الفردوسي إلى السعدي، مجلّدان، ترجمة: إبراهيم أمين الشواربي، مطبعة السعادة بمصر، 1373هـ/ 1954م.
* بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، تراجم سيدات بيت النبوة، دار الكتاب العربيّ، بيروت، 1404هـ/1984م.
* بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، السيدة زينب (بطلة كربلاء)، مؤسّسة دار الهلال، ط2، 195.
* بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، موسوعة آل النبي، موسّسة دار الهلال، ط2.
* البياتي، شوكت عبد الكريم، تطوّر فن الحكواتيّ في التراث العربيّ في المسرح العربيّ المعاصر، دار الشؤون الثقافيّة العامّة، بغداد، 1989م.
(ت)
* التبريزيّ، آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد (1926 ـ 2006م)، الأنوار الإلهيّة في المسائل العقائديّة، منشورات دار الصديقة الشهيدة، قم، ط1، 1422هـ.
(ج)
* جامع أحاديث الشيعة، السيد حسين الطباطبائي البروجردي، المطبعة العلمية، قم، 1380هـ ق.
(ر)
الراعي، علي، المسرح في الوطن العربيّ، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1410هـ/ 1990م).
* رضا، الشيخ احمد، متن معجم اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1379هـ/1960م.
(س)
* سيد الأهل، عبد العزيز، زين العابدين، (علي بن الحسين)، مكتبة وهبة، القاهرة، ط2، 1961م.
(ش)
* شرف الدين، السيد عبد الحسين (المتوفى سنة 1377هـ) المجالس الفاخرة في مآتم العترة الطاهرة، مراجعة وتحقيق: محمود البدري، مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، قم، ط1، 1421هـ.
* الشرقاوي، عبد الرحمن، الحسين ثائراً وشهيداً، منشورات مركز السيّد الصدر للابحاث العربيّة والإسلاميّة (باريس)، ط4، 1430هـ/2009م.
* شريف القرشيّ، باقر، حياة الإمام الحسين بن علي×، دراسة وتحليل، تحقيق مهدي باقر القرشيّ، الناشر قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة الحسينيّة المقدّسة (3 أجزاء)، الطبعة 2، 1429هـ/ 2008م.
* شمس الدين، الشيخ محمّد مهدي، ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعيّة وآثارها الإنسانية، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، ط7، 1417هـ.
* الشهرستانيّ، السيد صالح، تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن علي× (مجلّدان) تحقيق وإعداد: الشيخ نبيل رضا علوان، دار الزهراء، بيروت.
* الشهرستانيّ، السيد هبة الدين الحسينيّ، نهضة الحسين×، تحقيق مؤسّسة إحياء الكتب الإسلاميّة، دار البلاغ، دار سلوني، بيروت، ط1، 1424هــ/ 2003م.
* الشيرازيّ، السيد حسن، الشعائر الحسينيّة، دار الصادق، بيروت، 1384هـ.
(ص)
* صادق، عبد الحسين، سيماء الصلحاء، طبع في مطبعة العرفان، صيدا، سنة 1345هـ /1927م)
* صبحي، أحمد محمود، نظريّة الإمامة عند الشيعة الاثني عشريّة، دار المعارف بمصر، 1969م.
* الصحيح من سيرة الإمام الحسين بن علي×، إشراف العلامة السيد مرتضى العسكري ـ المحقق السيد محمّد باقر شريف القرشي والمؤرخ السيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1430هـ/2009م.
(ط)
* طه حسين، الفتنة الكبرى، علي وبنوه، (3 مجلّدات)، دار المعارف، القاهرة، ط 13.
* الطهرانيّ، الشيخ آغا بزرك، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، (25 مجلداً)، دار الأضواء، بيروت.
(ع)
عاشور، علي، موسوعة الإمام الحسين، معرفة الإمام الحسين عبادة الحسين ومكارم أخلاقه، دار نظير عبود، بيروت، ط1، 1432هـ/2011م.
* عبّاس، دلال، بهاء الدين العامليّ أديباً وفقيهاً وعالمـاً، دار الحوار، بيروت 1995، دار المؤرّخ العربيّ، 2010.
* العزاوي، عبّاس، العراق بين احتلالين، منشورات الشريف الرضي، قم، ط1، 1410هـ/1990م.
(ف)
* فروخ، عمر، تاريخ الأدب العربيّ، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1979م؛ ط7، 2006م.
(ق)
* قربان زاده، بهروز، عمر الخيام بين آثار الدارسين العرب، دراسة أدبيّة نقديّة مقارنة، دار الإرشاد، بيروت، 1432هـ/ 2011م.
(ك)
* الكاظمي، عبد المنعم، مقتل سيد الأوصياء ونجله سيد الشهداء، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1414هـ/1993م.
* الكرباسي، محمّد صادق محمد، دائرة المعارف الحسينيّة، معجم خطباء المنبر الحسينيّ، المركز الحسينيّ للدراسات، لندن، ط1، 1419هـ/ 1999م.
* الكرباسي، محمّد صادق محمد، دائرة المعارف الحسينيّة، معجم المصنفات الحسينيّة، المركز الحسينيّ للدراسات، لندن، ط1، 1419هـ/1999م.
* الكرباسي، محمّد صادق محمد، دائرة المعارف الحسينيّة، معجم بأسماء خطباء المنبر الحسينيّ، المركز الحسينيّ للدراسات، لندن، ط1، 1419هـ/ 1999م.
* الكليدار، آل طعمة، عبد الحسين، بغية النبلاء في تاريخ كربلاء، مطبعة الارشاد، بغداد، لا تا.
(م)
* متز، آدم، الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط5.
* محدثي، جواد، موسوعة عاشوراء، ترجمة خليل زامل العصامي، دار الرسول الأكرم، دار المحجّة البيضاء، بيروت، ط1، 1418هـ/ 1997م.
* مغنية، محمّد جواد، الشيعة والتشيع، مكتبة المدرسة ودار الكتب اللبناني، بيروت، منشورات شريف الرضي، قم، ط2، 1405هـ.
* مغنية، محمّد جواد، الشيعة والحاكمون، دار ومكتبة الهلال ـ دار الجواد، بيروت، الطبعة الأخيرة، 1421هـ/ 2000م.
* المقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ط 5، 1399هـ/1979م.
* المقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين، الناشر: مكتبة ال علي، قم، ط1، 1424هـ /2003م.
* منیمنة، حسن، تاريخ الدولة البويهية، الدار الجامعية، بيروت، 1407هـ/1987م.
* معلوف، لويس، المنجد في اللغة، دار المشرق، بيروت، ط 21، 1973م.
(ن)
* نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، ط14، 2007م.
* ندا، طه، الأدب المقارن، دار النهضة العربيّة، بيروت، لا تا.
* نقدي، الشيخ جعفر بن محمّد (1303 ـ 1370هـ)، تاريخ الإمامين الكاظمين÷ وروضتهما الشريفة من يوم دفنهما إلى زماننا الحاضر، تحقيق: الشيخ غزوان سهيل الكليدار، الناشر الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، دار الر افدين، بيروت، ط 1، 1435هـ/2014م.
(و)
* الوردي، علي، لمحات اجتماعيّة من تاريخ العراق الحديث (6 اجزاء)، منشورات الشريف الرضي، قم، إيران، ط1.
* مقال: (التكية والتوحيدخانه والخانقاه في إيران)، بقلم الدكتور محمّد نور الدين عبد المنعم، استاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ـ مصر. منشور في مجلة شيراز، العدد: 12، طهران.
* مقال: (ثورة الحسين وأثرها في الأدب المحلي)، منشور في صحيفة الوسط البحرينيّة، بتاريخ 25/3/2003م.
* مقال (الحسين ثائراً والحسين شهيداً)، بقلم حسين الهلالي منشور
في مجلة الحوار المتمدن، العدد 2163 بتاريخ 17 ـ 1 ـ 2008م عنوان الموقع:
http: // ahewar.org
* مقال: (دراسات المستشرقين عن الإمام الحسن السبط×)، دونالدسون نموذجا، بقلم علي زهير هاشم، مجلة مركز دراسات الكوفة، العدد 30، لسنة 2013.
* مقال: (رضا عبّاسي، رسّام الجداريات الضخمة) موقع الاذاعة الإيرانيّة باللغة العربيّة على شبكة الانترنت: http: //arabic.irib.ir.reporter/item.iran arabic radio. .
* مقال عن (مسرحيّة الحسين شهيداً والحسين ثائراً)، منشور في موقع مصرس نقلاً عن صحيفة الفجر بتاريخ 24 ـ 3 ـ 2012.www.masress.com
* مقال عن (مسرحيّة الحسين شهيداً والحسين ثائراً)، منشور في موقع مصرس نقلاً عن صحيفة اليوم السابع، بتاريخ 1 ـ 12 ـ 2010. www.masress.com
* مقال عن (مسرحيّة الحسين شهيداً والحسين ثائراً)، منشور في موقع مصرس نقلاً عن مجلة روز اليوسف بتاريخ 13 ـ 3 ـ 2010.
* مقال عن (كتاب مسرح التعزية في العراق) بقلم إبراهيم حاج عبدي، منشور في صحيفة المدى العراقيّة.
* تقرير
لوكالة أنباء رويترز بتاريخ 23 فبراير2004 م، بعنوان (عاشوراء... عمل
مسرحيّ احترافيّ لأوّل مرّة في لبنان) بقلم: ليلى بسام. العنوان:
http: //www.reuters.com/locales/newsA...toryID=4416414.
* مقال (فصول من تاريخ المسرح العراقيّ) بقلم: لطيف حسن. منشور في موقع الناس في شبكة الانترنت www.alnnas.com.
* مقال (المسرح الدينيّ)، التعزية، بقلم محمّد سيف، منشور في موقع: www.alimezher.com
* مقال (ماهي التعازي الحسينيّة في العراق) بقلم: لطيف حسن. موقع الناس في شبكة الانترنت. www.alnnas.com
* مقال حول (كتاب مسرح التعزية في العراق) في موقع: http: //albayan. ar/books
* مقال شعر النواح والبكاء، شعر المقتل، سردية قصصية، محمّد سيف، باريس
www.alimizher.com
* مقال فصولمنتاريخالمسرحالعراقيّ–كربلاءوتشابيهالمقتلوالتعازيالحسينيّةفيعاشوراء، لطيفحسن، منشورفيموقعالناس. nnas.com www.al ـ
* الأدب العربيّ http: // ara.bi/poetry.com.
* مركز الأبحاث العقائديّة http: //www.aqaed.com.
* كربلاء المقدسّة http: // holy karbala. net /abu alhab/ 16.html.
* موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرّة، باللغة العربيّة ar.wikipedia.org/wiki/.
* المحدّث النوري الطبرسيّ، حسين بن محمّد تقي، لؤلؤ ومرجان في وظائف الخطباء والوعاظ، مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ ـ قسم المخطوطات، طهران.
(أ)
* ابن البلخي، فارسنامه، تصحيح: غاي ليترانج، منشورات أساطير، طهران، ط1، 1385هـ.ش [2006م].
* ابن تاج الدين حسن سلطان محمد، كليات تحفة المجالس در معجزات چهارده معصوم^، [كليات تحفة المجالس في معجزات أربعة عشر معصوماً]، منشورات كتابجي، طهران، ط3، 1369هـ.ش [1990م].
* اشبولر، برتولد، تاريخ مغول در إيران [تاريخ المغول في إيران]، ترجمه بالفارسيّة منصور مير آفتاب، المنشورات العلميّة الثقافيّة، طهران، ط8، 1384هـ.ش [2005م].
* الإمام الخميني، صحيفه نور، (22مجلّداً) من منشورات وزارة الثقافة والارشاد الإسلاميّ الإيرانيّ، طهران، ط1، 1369هـ.ش [1990م].
* أورلئاريوس، آدم، اصفهان خونين شاه صفي (سفرنامه) [مدوّنة الرحلة إلى إصفهان الدامیة في عهد الشاه صفي]، ترجمة مهندس حسين كردبجه، منشورات هيرمند، طهران، 1379هـ.ش [2000م].
(ب)
* باذل، ميرزا محمّد رفيع بن محمّد المشهدي (المتوفّى في العام 1124)، حمله حيدري در مناقب علي× (في مناقب الإمام علي)، المكتبة الإسلاميّة، طهران، مجلّدان، ط2، 1361هـ.ش [1982م].
* بیغ منشی، إسكندر، تاريخ عالم آراى عبّاسى [تاریخ العالم في عصر الشاه عبّاس الصفويّ]، تصحيح: الدكتور محمّد إسماعيل رضواني، الناشر: دنيا الكتاب، (3 مجلّدات)، ط1، 1377هـ.ش [1998م].
* بنجامين، س. ج. سفرنامه إيران وإيرانيان [الرحلة إلى إيران، والإيرانیّون]، ترجمه بالفارسيّة: محمّد حسين كردبجه، منشورات جاويدان، طهران، لا تا.
* بیتر دلا فاله، سفرنامه بیتر دلا فاله [رحلة بیتر دلا فاله]، ترجمة: شجاع الدين شفا، منشورات: الشركة العلميّة والثقافيّة للنشر، طهران، 1370هـ.ش [1991م].
(ت)
* تافرنيه، سفرنامه تافرنيه [رحلة تافرنيه]، ترجمه بالفارسيّة أبو تراب نوري، تصحيح حميد شيراني، منشورات مكتبة سنائي، 1369هـ.ش [1990م].
* تنكابني، ميرزا محمّد بن سليمان، قصص العلماء، تحقيق: محمّد رضا برزكر خالقي وعفت كرباسي، المنشورات العلميّة الثقافيّة، طهران، ط3، 1390 هـ.ش [2011م].
(ج)
* جوهري المروزيّ، ميرزا محمّد إبراهيم (المتوفّى في العام 1252هـ)، طوفان البكاء، در مصائب ائمه اطهار بخصوص سيد الشهداء [طوفان البكاء في مصائب الأئمّة الأطهار لا سيّما سید الشهداء]، منشورات طوباي محبت، ط1، 1390هـ.ش [2011م].
* الجوينيّ، علاء الدين عطا ملك محمّد بن محمد، تاريخ جهانگشاى جوينى [تاریخ فتح العالم للجوینيّ]، (3 مجلدات) نشر علم، 1387هـ.ش [2008م].
* جهانغشاي خاقان، تاريخ شاه إسماعيل الصفويّ، دكتر الله مضطر، منشورات مركز التحقيقات الفارسيّة إيران وباكستان، إسلام آباد، 1364هـ.ش [1985م].
(ح)
* حافظ أبرو، زبدة التواریخ، تصحيح: سيد كمال حاج سيد جوادي، منشورات ني، ط1، 1372هـ.ش [1993م].
(د)
* دوغوبینو، كنت، سفرنامه، سه سال در آسيا 1858 ـ 1855 [مدوّنة الرحلة، ثلاث سنوات في آسيا1855ـ 1858]، ترجمه بالفارسيّة عبد الرضا هوشنغ مهدوي، منشورات شركت كتاب سرا، ط1، 1367هـ.ش [1988م].
* ديولافوا، سفرنامه ديولافوا در عصر قاجار [رحلة ديولافوا في العصر القاجاري]، ترجمه بالفارسيّة بهرام فره وشي، منشورات مكتبة خيام، ط2.
(ر)
* الراوندي، نجم الدين أبو بكر محمّد بن علي بن سليمان، راحة الصدور وآية السرور، در تاريخ آل سلجوق، تصحيح: محمّد إقبال، منشورات أساطير، طهران، ط1، 1386هـ.ش [2007م].
(س)
* السمرقنديّ، كمال الدين عبد الرزاق، مطلع السعدَين ومجمع البحرَين، إعداد: عبد الحسين نوائي، منشورات: مركز أبحاث العلوم الإنسانيّة والدراسات الثقافيّة]، طهران، ط1، 1383هـ.ش [2004م].
* سيف، هادي، نقاشي قهوه خانه اى [رسوم المقاهي]، الناشر: مؤسّسة التراث الثقافيّ الوطنيّ، 1369هـ.ش [1990م].
(ش)
* شوشتري، العلّامة قاضي نور الدين، مجالس المؤمنين، (مجلّدان) منشورات المكتبة الإسلاميّة، طهران، 1354هـ.ش [1975م].
(ص)
* صالحي نجف آبادي، شهید جاوید حسین بن علی× [الشهید الخالد الحسین بن علي]، مطبعة مشعل الحريّة، طهران، ط 2.
(غ)
* غرديزي، أبو سعيد عبد الحي بن ضحاك بن محمود، زين الأخبار، إعداد: رحيم رضا زاده ملك، منشورات: مؤسّسة الآثار والمعالم الثقافيّة، طهران، 1384هـ.ش [2005م].
* غریان شهرابي أردستاني، محمّد حسين بن عبد الله، طريق البكاء، در مصائب خامس آل عبا× [طريق البكاء في مصائب خامس آل عباء×] المنشورات الإسلاميّة، طهران، 1379هـ.ش [2000م].
* غلستانه، أبو الحسن بن محمّد أمین، مجمل التواریخ، إعداد: مدرس رضوي، منشورات: مكتبة ابن سينا، طهران، ط1، 1344هـ.ش [1965م].
(ف)
* الفسائيّ، حاج ميرزا حسن حسيني، فارسنامه ناصري، تصحيح: منصور رستغار الفسائيّ، منشورات: أمير كبير، 1367هـ.ش [1988م].
* فرصت الشيرازيّ، محمّد نصير، آثار عجم [آثار العجم]، تصحیح وتحشیه: منصور رستغار الفسائيّ، منشورات: أمير كبير، طهران، 1377هـ.ش [1998م].
* فرانكلين، ويليام، مشاهدات سفر از بنگال به إيران [مشاهدات السفر من بنغال إلی إيران]، ترجمة: محسن جاويدان، منشورات المركز الإيرانيّ للبحوث التاریخيّة، طهران، 1358هـ.ش [1979م].
(ق)
* قزويني، يحيى بن عبد اللطيف، لُبّ التواريخ، تنقيح: مير هاشم محدث، منشورات جمعية الأثار والمفاخر الثقافية، طهران، 1386هـ.ش [2007م].
* قزويني الرازيّ، نصير الدين ابو الرشيد عبد الجليل، النقض المعروف بـ(بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض)، القرن السادس، تصحيح: مير جلال الدين محدّث، سلسلة منشورات الجمعیة الوطنیّة للآثار، طهران، 1385هـ.ش [2006م].
* القمّيّ، شيخ عبّاس، تحفة الأحباب في نوادر آثار الأصحاب، دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1370هـ.ش [1991م].
* القمّيّ، شيخ عبّاس، كليات مفاتيح الجنان، منشورات پيام آزادي، ط2، 1414هـ.
* القمّيّ، شيخ عبّاس، هدية الأحباب، تصحيح: غلامحسين أنصاري، منشورات شركت الطباعة والنشر الدوليّة، ط1، 1391هـ.ش [2012م].
(ك)
* الكاشانيّ، ملا حبيب الله شريف، تذكرة الشهداء (مقتل الإمام الحسین)، ترجمة: سید علی جمال أشرف، منشورات مدین، 1385هـ.ش [2006م].
* كمبفر، انغلبرت، سفرنامه [الرحلة]، ترجمة: كيكاووس جهانداري، منشورات شركة خوارزمي المساهمة، ط2، 1360هـ.ش [1981م].
* كورزن، جورج، ن، إيران وقضيه إيران، ترجمه بالفارسيّة غلامعلي وحيد مازندراني، منشورات شركة المنشورات العلميّة والثقافيّة.
(م)
* محمّد شفيع طهران، مرآت واردات، تاريخ سقوط صفويان [مرآة المستوردات، تاریخ سقوط الصفویّین]، قدّم له وعلّق عليه: منصور صفت غل، منشورات: مركز نشر التراث المدوّن، طهران، ط1، 1383هـ.ش [2004م].
* مروي، محمّد كاظم، عالم آراى نادرى [تاریخ العالم في عصر نادر شاه]، تصحيح: محمّد أمين رياحي، مكتبة زوار، (ثلاثة مجلّدات)، ط1، 1364هـ.ش [1985م].
* مستوفي قزويني، حمد الله، نزهة القلوب، تصحيح: الدكتور محمّد دبير سياقي، منشورات حديث اليوم، ط1، 1381هـ.ش [2002م].
* مستوفي قزويني، حمد الله، تاريخ گزیده [التاریخ المختصر]، دكترعبد الحسين نوائي، منشورات أمير كبير، ط1، 1361هـ، 1362هـ.ش [1983م.
* مستوفي، عبد الله، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی واداری دوره قاجاریه [سيرة حیاتي، أو التاريخ الاجتماعيّ والإداريّ في العصر القاجاريّ]، مكتبة محمّد علي علمي، طهران، 1324هـ.ش [1945م].
* المقدسي، أبو عبد الله محمّد بن أحمد، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ترجمه بالفارسیّة: الدكتور علينقي منزوي، منشورات شركة مؤلّفي ومترجمي إيران، (مجلّدان)، ط1، 1361هـ.ش [1982م].
* منشي، اسكندر بيك، تاريخ عالم آراى عبّاسى [تاریخ العالم في عصر شاه عبّاس الصفويّ]، تصحيح: محمّد إسماعيل رضواني، (3 مجلّدات) منشورات: دنيا الكتاب، ط1، 1377هـ.ش [1998م].
* موريه، جيمز، سه سال در دربار إيران، خاطرات دكتر موريه پزشك ويژه ناصر الدین شاه [ثلاث سنوات في البلاط الإيرانيّ، مذكّرات الدكتور موريه الطبیب الخاصّ لناصر الدین شاه القاجاريّ]، ترجمه بالفارسيّة عبّاس إقبال الآشتيانيّ، بجهود همايون شهيدي، منشورات: دنيا الكتاب، ط2.
* ميرخواند، محمّد بن خاوند شاه بن محمود، تاريخ روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا، تصحيح: جمشيد كيان فر، منشورات أساطير، طهران، ط1، 1380هـ.ش [2001م].
ملاحظة: تاريخ روضة الصفا المؤلَّف من 15 مجلّداً، كتبه ميرخواند ولم يتمكّن من إكماله، بل كتبَ عشرة أجزاء منه، وقام حفيده خواندمير بكتابة الجزء 11 منه، وأتمّ الكتاب أي من المجلد 12 إلى المجلّد 15 رضا قلي خان هدايت.
(ن)
* نرشخي، أبو بكر محمّد بن جعفر (286 ـ 348هـ) تاريخ بخارا [تاریخ بخاری]، ترجمه بالفارسيّة أبو نصر أحمد بن محمّد بن نصر القبادي، تصحيح: مدرس رضوي، منشورات طوس، طهران، ط2، 1363هـ.ش [1984م].
* نظامى غنجوي، مخزن الأسرار، انتخاب وتوضیح: الدكتور كامل أحمد نجاد، منشورات سخن، طهران، ط1، 1374هـ.ش [1995م].
(و)
* واعظ كاشفي، ملا حسين (المتوفّی في العام 910هـ)، روضة الشهداء، تصحيح: آية الله حاج شيخ أبو الحسن الشعرانيّ، منشورات المكتبة الإسلاميّة، لا تا.
(أ)
* آجند، يعقوب، نمايش در دوران صفوی [المسرح في العصر الصفويّ]، منشورات مؤسّسة التأليف والترجمة والنشر للآثار الفنّيّة، طهران، ط2، 1388هـ.ش [2009م].
* ارج نامه، ذبيح الله صفا، سيد علي آل داود، 1390هـ.ش [2011م].
* أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات نخستين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتی [مجموعة مقالات الندوة الدوليّة الأولى للعروض الدينيّة والتقليديّة]، منشورات جمعيّة العروض المسرحيّة، طهران، ط1، 1388هـ.ش [2009م].
* أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتی [مجموعة مقالات الندوة الدوليّة الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]، منشورات جمعيّة العروض المسرحيّة، طهران، ط1، 1390هـ.ش [2011م].
* استرابادي، ميرزا مهديخان، دره نادره [تاريخ عصر نادرشاه]، شركة المنشورات العلميّة الثقافيّة، بإشراف سيد جعفر شهيدي، ط2، 1366هـ.ش [1987م].
* اسفندياري، محمّد، كتابشناسى تاريخى امام حسين (ع) [ببليوغرافیا الإمام الحسین التاریخیّة]، منشورات: مؤسّسة طباعة ومنشورات وزارة الثقافة والتبليغ الإسلاميّ، ط1، طهران، 1380ه.ش [2001م].
* إسماعيل زاده، حسن، نقاش مكتب قهوه خانه اى [رسّام مدرسة رسوم المقاهي]، منشورات المؤسّسة الثقافيّة البحثيّة، منشورات: نظر، طهران، 1384هـ.ش [2005م].
* أشرفي، جهانغير نصري، از آيين تا نمايش [من الطقوس الدينيّة إلى العروض المسرحیّة]، (مجلّدان)، منشورات ارون، ط1، 1391هـ.ش [2012م].
* أشرفي، جهانغير نصري، نمايش وموسيقى در إيران [العروض المسرحیّة والموسیقى في إيران)، منشورات ارون، طهران، ط1، 1383هـ.ش [2004م].
* آقاسي، محمّد رضا، برمدار عشق [علی مدار العشق]، منشورات: مكتب تدوين وجمع آثار الأستاد محمّد رضا آقاسي، ط2، 1388هـ.ش [2009م].
* آغا عبّاسي، يد الله، دانشنامه نمايش إيرانى [دائرة معارف العرض المسرحيّ في إيران]، منشورات: قطره، طهران، ط1، 1389هـ.ش [2010م].
* إقبال، زهرا (نامدار)، جُنگ شهادت [دفتر الشهادة] (مجلّدان)، بإشراف: محمّد جعفر محجوب، منشورات سروش، طهران، ط 1، 1355هـ.ش [1976م].
* الأمين، محسن، عزادارى هاى نامشروع [التعازي غير الشرعيّة] (ترجمة لرسالة التنزيه لأعمال الشبيه)، ترجمة جلال آل أحمد، ط1، منشورات شروه، بوشهر، ط 2، 1371ه.ش [1992م].
(ب)
* بازار إيرانى [السوق الإيرانيّة]، دائرة العمران وتخطيط المدن التابعة لوزارة الإسكان والتنظيم المـُدني، منشورات الجهاد الجامعيّة ـ طهران، ط 1، 1388هـ.ش [2009م].
* باستاني باريزي، محمّد إبراهيم، سنگ هفت قلم، بر مزار خواجگان هفت چاه [حجر بسبعة أقلام، على مزار حراس سبعة عيون، منشورات العلم، ط 3، 1369هـ.ش [1990م].
* باستاني باريزي، محمّد إبراهيم، مار در بتكده كهنه [أفعی في معبد قدیم]، منشورات العلم، ط2، 1369هـ.ش [1990م].
* بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آيينى [قراءة التعزیة، حدیث المصائب القدسیّة في التمثیل الدینيّ]، منشورات أمير كبير، طهران، ط1، 1383هـ.ش [2004م].
* بلوكباشي، علي، نخل گردانی [النخل الدوّار]، مكتب البحوث الثقافيّة، طهران، ط1، 1380هـ.ش [2001م].
* بيضائي، بهرام، نمايش در إيران [العرض المسرحيّ في إيران]، منشورات المثقّفين والدراسات النسائيّة، طهران، ط8، 1391هـ.ش [2012م].
* بياني، شيرين، دين ودولت در عهد مغول [الدين والدولة في العصر المغوليّ]، منشورات مركز النشر الجامعيّ، طهران، ط1، 1367هـ.ش [1988م].
* بينيون، لورنس، و ج.و.س.ويلكينسون، سير تاريخى نقاشى إيران [المسیرة التاریخیّة للرسم في إيران]، ترجمة: محمّد إيرانمنش، منشورات أمير كبير، طهران، ط1، 1367هـ.ش [1988م].
* بارسا دوست، منوجهر، شاه اسماعیل اول [الشاه إسماعیل الأوّل]، منشورات شركه انتشار المساهمة، طهران، ط1، 1375هـ.ش [1996م].
* باكباز رویین، نقاشی در إيران، از دیروز تا امروز [الرسم في إيران، من ماضي الأيام إلى اليوم]، منشورات زرین وسیمین، طهران، ط10، 1390هـ.ش [2011م].
* بطروشفسكي، سربداران خراسان، ترجمه كریم كشاورز، دار نشر بیام، طهران، ط1، 1351هـ.ش [1972م].
* پیرنیا، حسن، تاریخ إيران باستان [تاریخ إيران القدیمة]، (3 مجلّدات)، مؤسّسة منشورات نگاه، طهران، ط4، 1386هـ.ش [2007م].
* بیشدار، رؤوف، تعزیه زمینه قزوین [التعزیة الخاصة بقزوین]، رسالة ماجستیر غیر مطبوعة، 1388هـ.ش [2010م].
(ت)
* تاریخ إيران كمبریدج (5 مجلّدات)، جمع: ج.آ.بریل، ترجمة حسن أنوشه، منشورات أمیر كبیر، طهران، ط 5،
1381هـ.ش [2002م].
* تاریخ هنر إيران [تاریخ الفنّ الإيرانيّ]، (مجلّدان) جهانغیر نصري أشرفي وعبّاس شیرزادي آهو دشتي، منشورات آرون، طهران، ط1، 1388هـ.ش [2009م].
* تركمني آذر، بروین، ديلميان در گستره تاریخ إيران (حكومتهاى محلى آل زيار، آل بويه) [الديالمة في إيران على مدى التاريخ (حكومات آل زيار وآل بويه المحلّيّة)]، منشورات مؤسّسة دراسة وتدوين كتب العلوم الإنسانيّة في الجامعات (سمت)، طهران، ط 1، 1384هـ.ش [2005م].
* تشلكوفسكي، بيتر. جي، تعزيه، هنر بومى پيشرو إيران [عروض التعزية، الفنّ المحلّيّ الطليعي الإيرانيّ]، ترجمه بالفارسيّة داود حاتمي، منشورات الشركة العلميّة والثقافيّة للنشر، طهران، ط 1، 1367هـ.ش [1988م].
* تشلكوفسكي، بيتر. جي، تعزيه: آیین ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، ترجمه بالفارسيّة داود حاتمي، منشورات مؤسّسة دراسة وتدوين كتب العلوم الإنسانيّة في الجامعات (سمت)، ط 2، 1389هـ.ش [2010م].
* تشيد علي أكبر، قهرمانان إسلام [أبطال الإسلام]، (مجلّدان)، ط 1، 1342هـ.ش [1962م].
* تقيان، لاله، تعزيه وتئاتر در إيران [التعزية والمسرح في إيران]، منشورات مركز، طهران، ط1، 1374هـ.ش [1995م].
(ج)
* جعفریان، رسول، أطلس شيعه [أطلس الشيعة]، منشورات: المديريّة الجغرافيّة للقوّات المسلّحة (إيران)، ط1، 1387هـ.ش [1998م].
* جعفریان، رسول، تاريخ تشيع در إيران، از آغاز تا قرن هفتم هجرى [تاریخ التشیع في إيران، من البدایة وحتی القرن السابع الهجري]، منشورات مؤسّسة التبليغ الإسلاميّ، طهران، ط5، 1377هـ.ش [1998م].
* جعفريان، رسول، دنباله جستجو در تاريخ تشيع در إيران [مواصلة البحث عن تاريخ التشيّع في إيران]، منشورات أنصاريان، قم، 1374هـ.ش [1995م].
* جرداق، جورج، علي صوت العدالة الإنسانيّة، علي والقوميّة العربيّة، ترجمة: سيد هادي خسرو شاهي، منشورات كلبه شرق، ط 10، 1379هـ.ش [2000م].
* جميلي، عبّاس خدوم، تعزيه در عراق و چند كشور إسلامی [التعزية في العراق وفي عدد من البلدان الإسلامیّة]، ترجمة مجيد سرسنكي، منشورات: أكاديميّة الفنّ، ط1، 1385هـ.ش [2006م].
* جنتي عطائي، أبو القاسم، بنياد نمايش در إيران [جذور العروض المسرحیّة في إيران]، منشورات ابن سينا، طهران، 1333هـ.ش [1955م].
(ح)
* حبيبي، نجفقلي، كتابشناسى امام حسين، [ببلیوغرافیا الإمام الحسین] منشورات مؤسّسة تنظيم ونشر مؤلفات الإمام الخمينيّ، طهران، 1996م.
* حسيني، ناصر، تئاتر معاصر إيران [المسرح الإيرانيّ المعاصر]، منشورات العروض، مركز العروض الفنيّة الوطنيّة، طهران، ط1، 1377هـ.ش [1998م].
* حسيني كازروني، السيد أحمد، تاريخ البيهقي، منشورات مؤسّسة آیات الثقافيّة، ط1، 1374هـ.ش [1995م].
* حكيميان، أبو الفتح، علويان طبرستان بحث في أحوال وآثار وعقائد الفرقة الزيديّة في إيران [علویّو طبرستان، بحث عن أحوال وآثار ومعتقدات الفرقة الزیدیّة في إيران]، منشورات جامعة طهران، 1348هـ.ش [1969م].
* حقوقي، محمّد، ادبيات امروز إيران، نظم ونثر [أدب إيران المعاصر، نظماً ونثراً]، منشورات قطره، طهران، 1380هـ.ش [2001م].
(خ)
* خلج، منصور، نمايشنامه نويسان إيران، از آخوندزاده تا بيضايى [المسرحيّون الإيرانيّون، من آخوند زاده إلی بيضائي)، منشورات اختران، طهران، ط1، 1381هـ.ش [2002م].
(د)
* دانش بجوه، منوجهر، بررسى سفرنامه هاى دوره صفوى [دراسة كتب الرحلات في العصر الصفويّ]، منشورات مجمع الفنّ في إصفهان، ط1، 1382هـ.ش [2003م].
* دانشنامه جهان إسلام [موسوعة العالم الإسلاميّ] بإشراف: غلامعلي حدّاد عادل، مؤسّسة دائرة المعارف الإسلاميّة، طهران، ط1، 1382هـ.ش [2003م].
* دانشنامه شعر عاشورایی ـ شاعران عرب [موسوعة شعر عاشوراء ـ الشعراء العرب]، منشورات مؤسّسة طباعة ونشر وزارة الثقافة والتبليغ الإسلاميّ، ط1، 1383هـ.ش [2004م].
* دانشنامه مزديسنا [دائرة معارف مزدیسنا]، تأليف: جهانغیر أوشیدري، نشر مركز، طهران، 1371هـ.ش [1992م].
* دانشنامه نمايش إيرانى [موسوعة العرض المسرحيّ الإيراني]، آغا عبّاسي، يد الله، منشورات قطره، 1389هـ.ش [2010م].
* دايرة المعارف بناهاى تاريخى إيران در دوره إسلامى، مدارس و بناهاى مذهبى [دائرة معارف المباني التاريخيّة في إيران في العصر الإسلاميّ، المدارس والمباني الدينيّة]، كاظم ملازاده، مريم محمدي، منشورات حوزه الفنون في مؤسّسة التبليغات الإسلاميّة، ط1، 1381هـ.ش [2002م].
* دايرة المعارف تشيع [دائرة معارف التشيّع]، صدر حاج سيد جوادي، أحمد، منشورات مؤسّسة تحقيقات ونشر معارف أهل البيت^.
* دايرة المعارف جهان نوين إسلام [دائرة معارف العالم الإسلاميّ الحديث]، ترجمة وتحقيق: حسن طارمي راد، منشورات كتاب مرجع، منشورات المجلس، 1388هـ.ش [2009م].
* دايرة المعارف فارسى [دائرة المعارف الفارسيّة]، غلام حسين مصاحب، (مجلّدان)، منشورات أمير كبير، ط4، 1383هـ.ش [2004م].
* دومين همايش سراسرى آیین هاى عاشورايى [الملتقى الثاني الموسّع للطقوس العاشورائيّة]، منشورات الإدارة العامّة للفنون المسرحيّة، طهران، ط1، 1384هـ.ش [2005م].
* دهخدا، لغت نامه دهخدا، [معجم دهخدا]، (14 مجلّداً) منشورات جامعة طهران، ط1، 1373هـ.ش [1994م].
(ر)
* راجر سيوري، إيران عصر صفوى [إيران في العصر الصفويّ]، ترجمه بالفارسيّة كامبيز سيوري، منشورات مركز، طهران، . ط4، 1374هـ.ش [1995م].
* رازي، فريدة، نقالى وروحوضى [قراءة شعر الملاحم]، منشورات مركز، طهران، ط1، 1390هـ/ 2011م.
* رباني خلخالي، علي، عزادارى از ديدگاه مرجعيت شيعه [التعزیة من وجهة نظر المرجعیّة الشیعیّة]، منشورات مكتب الحسين، قم.
* رحلة ابن بطوطة [سفرنامه ابن بطوطه] ترجمة: محمّد علي موحد، منشورات علمي فرهنكي، ط1، 1361هـ.ش [1982م].
* ربيكا، یان، تاريخ ادبيات إيران [تاریخ الأدب في إيران]، منشورات غوتنبرغ، وجاويدان خرد، طهران، ط1، 1370هـ.ش [1991م].
* ري شهري، محمّد محمدي، فرهنگ نامه مرثیه سرایی وعزاداری سید الشهدا× [موسوعة قراءة المراثي والتعزية على سيّد الشهداء×]، منشورات دار الحدیث، قم 1387هـ.ش [2008م].
(ز)
* زرين كوب، عبد الحسين، تاريخ إيران بعد از إسلام [تاريخ إيران بعد الإسلام]، منشورات أمير كبير، طهران، ط 15، 1392هـ.ش [2013م].
(س)
* ستاري، جلال، پرده های بازی [ستائر العرض المسرحيّ]، منشورات ميترا، طهران، ط1، 1379هـ.ش [2000م].
* سيف، هادي، نقاشى قهوه خانه اى [رسوم المقاهي]، منشورات: مؤسّسة التراث الثقافيّ الوطنيّ، طهران، لاتا.
* سيوري، راجر، إيران عصر صفوى [إيران في العصر الصفويّ]، ترجمه بالفارسيّة كامبيز عزيزي، نشر مركز، ط 4، 1374هـ.ش [1995م].
(ش)
* شريعتي، علي، تشيع صفوى وتشيع علوى [التشيع الصفويّ والتشيع العلويّ]، لا ط.، لا تا.
* شفق، رضا زاده، نادر شاه، منشورات ثالث، طهران، ط1، 1392هـ.ش [2013م].
* الشيبي، كامل مصطفى، تشيّع وتصوّف، تا آغاز سده دوازدهم هجري [التشيّع والتصوّف، إلى بداية القرن الثاني عشر الهجريّ]، ترجمه بالفارسيّة عليرضا ذكاوتي قراغوزلو، مؤسّسة أمير كبير، طهران، ط1، 1359هـ.ش [1980م].
(ص)
* صالحي راد، حسن، مجالس تعزيه [مجالس التعزية]، (مجلّدان)، منشورات سروش، طهران، 1380هـ.ش [2001م].
* صديقي، غلامحسين، جنبش هاى دينى إيرانى در قرن هاى دوم وسوم هجرى [الحركات الدينيّة الإيرانيّة في القرنين الثاني والثالث الهجريّين]، منشورات باجنك، طهران، ط1، 1372هـ.ش [1993م].
* صفا، ذبيح الله، گنج سخن [كنز الكلام]، دار نشر ققنوس، طهران، ط8، 1367هـ.ش [1988م].
* صفر علي بور، حشمت الله، كتابشناسى امام حسين× [ببليوغرافيا الإمام الحسين×]، معهد التحقیقات الإسلاميّ لممثليّة الوليّ الفقيه، قم، 1998م.
(ض)
* ضيائي، سيد عبد الحميد، جامعه شناسي تحريفات عاشورا [تحريفات عاشوراء من وجهة نظر علم الاجتماع]، دار نشر هزاره ققنوس، طهران، ط3، 1387هـ.ش [2008م].
(ع)
* عاشورا در گذر به عصر سكولار [عاشوراء وصولاً إلى عصر العلمانيّة]، مجموعة مقالات، من منشورات كوير، طهران، ط1، 1383هـ.ش [2004م].
* عاشورانامه [موسوعة عاشوراء]، مركز الدراسات الاسترتيجيّة والعسكريّة (6 مجلّدات)، منشورات خيمة، قم، ط 1 1388هـ.ش [2009م].
* عاشور بور، صادق، نمايش هاى إيرانى [العروض المسرحيّة الإيرانيّة]، منشورات سوره مهر، ط 1، 1381هـ.ش [2002م].
*عرفان، حيدر، تعزيه در استان بوشهر [التعزية في محافظة بوشهر]، منشورات نويد، شيراز، ط1، 1379هـ.ش [2000م].
(ف)
* فصلنامه هنر [فصليّة الفنّ]، مجموعة من المؤلّفين، بإشراف السيّد كمال حاج سيد جوادي، بجهود: أمير لواساني، منشورات الشركة المساهمة لمطبعة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ، طهران، العدد: 4، 1364هـ.ش [1985م].
* فصيح خوافي، مجمل فصيحي، مقدّمة وتصحيح وتحقيق: السيّد محسن ناجي نصر آبادي، منشورات أساطير، طهران، ط1، 1386هـ.ش [2007م].
* فقيهي، علي أصغر، آل بويه، نخستين سلسله قدرتمند شيعه [آل بويه، أوّل سلالة شيعيّة قويّة]، دار نشر صبا، ط3، طهران، 1366هـ.ش [1987م].
* فلاح زاده، تاریخ اجتماعی ـ سیاسی تآتر در إيران [التاریخ الاجتماعيّ والسیاسيّ للمسرح في إيران]، منشورات بجواك كیهان، تهران، 1393هـ.ش [2014م].
* فلسفي، نصر الله، زندگانى شاه عباس اول [حیاة الشاه عبّاس الأوّل]، منشورات محمّد علي العلمي، طهران، 1369هـ.ش [1990م].
* فيض، ميرزا عباس، تاريخ كاظمين، (مجلّدان)، قم، 1327ه.ش [1948م].
(ك)
* كليفورد باسورث، إدموند، تاريخ غزنويان [تاريخ الغزنويّين]، ترجمه حسن أنوشه، منشورات أمير كبير، (مجلّدان)، طهران، 1372هـ.ش [1993م].
* كياني، محسن، تاريخ خانقاه در إيران [تاريخ الخانقاه في إيران]، منشورات طهوري، طهران، ط1، 1369هـ.ش [1990م].
(م)
* متز، آدم، تاريخ تمدن إسلامى در قرن چهارم هجرى، [تاریخ الحضارة الإسلامیّة في القرن الرابع الهجريّ]، ترجمه بالفارسيّة محمّد حسين استخر، 1343هـ.ش [1964م].
* محدثي، جواد، فرهنگ عاشورا [موسوعة عاشوراء]، دار نشر معروف، قم، ط11، 1386هـ.ش [2007م].
*مرتضوي، منوجهر، مسائل عصر ايلخان [قضايا عصر الإيلخانيّين]، منشورات آگاه، ط1، 1358هـ.ش [1979م].
* مزاوي، ميشل، م، پیدایش دولت صفوی [نشأة الحكومة الصفويّة]، ترجمه بالفارسيّة الدكتور یعقوب آجند، منشورات گستره، طهران، ط2، 1368هـ.ش [1989م].
* مسعوديه، محمّد تقي، موسيقى مذهبى إيران [الموسیقی الدینیّة في إيران]، منشورات سروش، طهران، ط 1، 1367هـ.ش [1988م].
* معتمدي، السيّد حسين، عزادارى سنتى شيعيان در بيوت علماء وحوزه هاى علميه و كشورهاى جهان [التعزية التقليديّة للشيعة في بيوت العلماء والحوزات العلميّة ودول العالم]، منشورات عصر ظهور، ط1، 1378هـ.ش [1999م].
* معين، فرهنگ فارسى [معجم معين الفارسيّ]، (مجلّد واحد)، منشورات معين، ط7، 1384هـ.ش [2005م].
* ملك بور، جمشيد، ادبيات نمايشى در إيران [أدب العروض المسرحيّة في إيران]، (مجلّدان)، منشورات طوس، طهران، ط3، 1391هـ.ش [2012م].
* ملك بور، جمشيد، سير تحول مضامين در شبيه خوانى [مسيرة تطوّر مضامين الشبيه]، منشورات الجهاد الجامعيّ، طهران، ط 1، 1366هـ.ش [1987م].
* مطهري، مرتضى، تحريفات در واقعه تاريخى كربلا [تحریفات في واقعة كربلاء التاريخيّة]، منشورات صدرا، ط1، 1391هـ.ش [2012م].
* مطهري، مرتضى، حماسه حسينى [الملحمة الحسينيّة]، منشورات صدرا، ط 51، 1385هـ.ش [2006م].
* مطهري، مرتضى، خدمات متقابل إسلام وإيران [الخدمات المتبادلة بین الإسلام وإيران]، منشورات مكتب المنشورات الإسلاميّ، قم، ط2، 1360هـ.ش [1981م].
* مظلوم زاده، محمّد مهدي، سير تعزيه در كازرون [مسار التعزیة في كازرون]، منشورات مركز البحوث والدراسات والتقويم لبرامج الإذاعة والتلفاز في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، ط1، 1382هـ.ش [2003م].
* موسوي غرمارودي، سيد محمّد صادق، فرهنگ عاشورا [ثقافة عاشوراء]، منشورات مؤسّة الطباعة والنشر في وزارة الثقافة والتبليغ الإسلاميّ]، طهران، ط2، 1386هـ.ش [2007م].
* مير أحمدي، مريم، دين ومذهب در عصر صفوى [الدين والمذهب في العصر الصفويّ]، منشورات أمير كبير، طهران، ط1، 1363هـ.ش [1984م].
* میر مصطفی، حسین، نقاشی در قهوخانه [الرسم في المقهى]، مقتطف من آثار الأستاد أحمد خليلي والأستاد محمّد فراهاني، منشورات وجه الكوثر، ط1، 1387هـ.ش [2008م].
(ن)
* نصري أشرفي، جهانغیر، نمایش وموسیقی در إيران [العرض المسرحيّ والموسیقی في إيران]، منشورات ارون، ط 1، 1383هـ.ش [2004م].
* نصري أشرفي، جهانغیر، وعبّاس الشيرازيّ أهودشتي، تاريخ هنر إيران [تاریخ الفنّ الإيرانيّ]، منشورات ارون، طهران، ط1، 1388هـ.ش [2009م].
* نوائي، عبد الحسين، إيران عصر صفوى [إيران في العصر الصفويّ]، نشر مركز، طهران، ط2، 1386هـ.ش [2007م].
* نيازمند، رضا، شيعه در تاريخ إيران [الشیعة في تاریخ إيران]، منشورات حكايت قلم نوين، طهران، ط1، 1383هـ.ش [2004م].
(و)
* ورمازن، مارتن، آیین میترا [دیانة میترا]، ترجمة: نادر بزركزاد، منشورات الينبوع، طهران، ط9، 1393هـ.ش [2014م].
(هـ)
* همايوني، صادق، تعزيه در إيران [التعزية في إيران]، منشورات نويد، شيراز، ط1، 1368هـ.ش [1989م].
* همايوني، صادق، تعزيه وتعزيه خوانى [التعزية وقراءة التعزية]، لا تا.
* همايوني، صادق، حسينيه مشير [حسینیة مشیر]، منشورات سروش، طهران، ط2، 1371هـ.ش [1992م].
* همايي، جلال الدين، تاريخ ادبيات إيران [تاريخ الأدب في إيران] (مجلّدان)، مكتبة حقوقي، ط4، 1366هـ. ش [1987م].
* همايي، جلال الدين، ديوان سنا، بجهود: ماه دخت بانو همايي، طهران، نشر هما، ط1، 1364هـ.ش [1985م].
* هنري، مرتضى، تعزيه در خور(التعزية في الخور)، منشورات وزارة الثقافة والفنّ، طهران، 1354هـ.ش [1975م].
(ي)
* يوسفي، غلامحسين، ابو مسلم سردار خراسان [أبو مسلم، قائد خراسان]، منشورات شركة كتب الجيب المساهمة، طهران، ط3، 1368هـ.ش [1989م].
* يارشاطر، إحسان، شعر فارسى در نيمه اول قرن نهم [الشعر الفارسيّ في النصف الأوّل من القرن التاسع]، 1326هـ.ش [1947م].
* مقال: از خاطرات صبا [من مذكّرات صبا]، صبا، أبو الحسن، مجلّة الموسيقى، العدد 18 بهمن 1336هـ.ش [يناير 1958م].
* (تأثير اعتناق غازان خان الدين الإسلاميّ على سائر الأديان والمذاهب الموجودة في إيران)، بقلم: الدكتور محمّد كريم يوسف جمالي، في مجلّة الأبحاث التابعة لمركز أبحاث العلوم الإنسانيّة والدراسات الثقافيّة، السنة الثالثة، خريف 1387هـ.ش [2008م]، العدد 12.
* مقال (طقوس محرّم في الأناضول التركیّة)، بقلم: متين اند، في كتاب: تعزيه: آیین ونمایش در إيران [التعزیة: العروض التقليديّة في إيران].
* مقال (تأثير المسرح الأوروبي وتوغّل أساليبه التمثيليّة في التعزية) بقلم محمّد جعفر محجوب، في كتاب: تعزیه: آیین ونمایش در إيران [التعزیه: العروض التقليديّة في إيران].
* مقال (المسرح الإيرانيّ)، بقلم: أنریكو جرولی نقلاً عن نمایش در شرق [العرض المسرحيّ في الشرق]، مجموعة مقالات بالفارسیّة، جلال ستاري، 1367هـ.ش [1988م].
* مقال (عاشوراء والثورة الحسينيّة تتجلّی في شعر الشيعة)، بقلم: السيّد حسن سيدي وهوشنغ استادي، مجلّه أدبيات تطبيقي، السنة الثانية، العدد 8.
* مقال: (إقامة التعزیة في الهند)، بقلم: السيّد حسين علي جعفري، في كتاب: تعزيه: آیین ونمایش در إيران [التعزیة: العروض التقليديّة في إيران].
* مقال: (التعزیة وفلسفتها)، مایل بكتاش، في كتاب: تعزيه، هنر بومي پیشرو إيران [عروض التعزیة، الفنّ المحلّيّ الطلیعيّ الإيرانيّ].
* مقال: (التغییر والتحوّل في أدب وموسیقی التعزیة)، بقلم عنایت الله شهیدي، في كتاب تعزیه آیین ونمایش در إيران [التعزیة: العروض التقليدية في إيران].
* مقال: (تعزية الإيرانيّين على شهداء كربلاء في العصر الصفويّ والقاجاريّ)، صحيفة جام جم الإيرانيّة، بتاريخ 16 اسفند 1381 الموافق 16 آذار ـ مارس 2003م.
* مقال (الرثاء فی العصر القاجاريّ)، في كتاب: تعزیه آیین ونمایش در إيران [التعزیة: العروض التقليديّة في إيران].
* مقال: (الدراسات المختصة بعاشوراء في الغرب)، بقلم غلام احيا حسيني، فصليّة تاريخ الإسلام، الصادرة في مدينة قم، إيران، العدد 37، السنة العاشرة، ربيع 1388.
1. مركز تعليمات إسلامي واشنطن: md.org _http: //Ketaab,iec.
2. موقع الكاتب برويز ممنون: http: //www.parvismamnun.at.
3. موقع آية الله سيد علي خامنئي www.leader.ir..
4. ويكي شيعه موقع ويكي شيعه www.wikishias.ir/.
1. A Persian Translation of The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World (1995).
2. Benjamin, S.G.W., Persia and the Persians, London 1887.
3. Berezin, I. n., Petusbestviye Po severnoy Persii, kazan 1852.
4. Browne Edward Granville, Aliterary history of Persia from Firdawsi to Sadi,1906
5. Browne Edward Granville. A literary history of Persia. 1862 ـ 1926.
6. Browne, E. g., A Literary History of Persia, 4 Vols. Cambridge 1918.
7. A Year Amongst the Persians, London 1893.
8. Texier Charles, Description de l’Armenie et la Perse et la meaopotamie (2 volumes, Paris,1825.
9. Chelkowski, peter,J; Ta’ziyeh, Ritual and Drama in Iran, new York 1979.
10. Chardin, Voyages du chevalier Chardin, en Perse et d’autres lieux de l’orient, par L. Langles, 10 Vols, Paris 1811.
11. lord Curzon, Persis and the Persian Question. 2 Vols, London 1892.
12. Don Garcias De Silva Figuetoa
13. Donaldson. The Shiite Religion, London 1933.
14. Du Mans, R., Estat de la Perse en 1660, (Paris 1890).
15. Eckhard Neubauer, “Muharrm ـ Brauche in heutigen Persien.” Der Islam, 1972, Bd. 49, Heft 2,249 ـ 272 ff
16. E. Flaudin, Voyage en Perse (Paris,1841).
17. Eustach de Lorey Queer things about Persia 1907.
18. Ghodzko: Teather Persian,Choix de Teazies Paris,1878.
19. Lady Shell, Glimpses of Life and manners in Persia 1848 ـ 1853 (London,1856).
20. Adam Metz, History of Islamic Cilivilization Adam Metz
21. Iran Under The Safarids Kroger Savary Cambridge University Press, 1980.
22. Kaempfer E., Jeurney in Persia and Other Oriental Countries, 1736.
23. Litten, W., Das Drama in Persien In Arch Orientalni, volume II (1930).
24. Litten, W., Das Persiscbe Drama (Berlin ـ Leipziq.1929).
25. L’illrstre vouageur, avec un denombrement tres exact des choses Les Plus… curieuses.
26. Tavernie Batist, Les Six Voyages de Jean ـ 2 volumes Paris 1692.
27. Mamnoun, P: Ta’zyeh,Sehitische, Persische Passionsspiel, Wien,1967.
28. Mez, A., Die Renaissance des Islams, Heidelberg, 1922.
29. Olearius, A., Relation du voyage en Moscovie, Tartarie, et Perse, Paris 1639.
30. Du mans Raphael, Etat de la Perse en 1660 (Paris,1890 : Faranborough, Hants,1969).
31. Mazzaoui Micheel M The Origins Of The Safawids. Wiesbaden 1972.
32. Pietro Della Valle, Fameux voyage de.., 4 volumes, Paris, 1664.
33. Vanberg ,Hermana. meine Wanderungen und erlebnisse in Persien ـ Pest:
34. Heokenast,1861.
35. Yarshater, Ehsan: Ta’Ziya and Pre Islamic Mourning Rites in Iran, in Chelkowiski,1979.
|
المحتويات
[1] البقرة: آية31.
[2] الريشهري، محمّد، العلم والحكمة في الكتاب والسنّة: ص36، نقلاً عن قرّة العيون للفيض الكاشاني: ص 438.
[[3]][3] المجادلة: آية11.
[4] البقرة: آية129.
[5] آل عمران: آية164.
[6] الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
[7] البقرة: آية253.
[8] دايره المعارف جهان نوين إسلام [دائرة معارف العالم الإسلاميّ الحديث]، ترجمة وتحقيق: حسن طارمي راد، منشورات كتاب مرجع، منشورات المجلس، 1388هـ.ش [2009م]: ج 2، ص184.
[9] ابن منظور، لسان العرب: ج10، ص1101.
[10] دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا: ص5490.
[11] دايرة المعارف تشيع [دائرة معارف التشيّع]، صدر حاج سيد جوادي، أحمد، منشورات مؤسّسة تحقيقات ونشر معارف أهل البيت^: ص241.
[12] آجند، یعقوب، نمایش در دوره صفوی [العرض المسرحيّ في العصر الصفويّ]، مصدر سابق: ص17ـ18.
[13] النرشخي، أبو بكر محمّد بن جعفر تاريخ بخارا [تاریخ بخاری]، ترجمه بالفارسيّة أبو نصر أحمد بن محمّد بن نصر القبادي، تصحيح: مدرس رضوي، منشورات طوس، طهران: ط2، 1363هـ.ش [1984م]، ص24.
[14] A.Mongait ‘ Archeology in the U.S.S.R (Moskau: 1959)..
[15] آجند، یعقوب، نمايش در دوره صفوى [العرض المسرحي في العصر الصفوي]، مصدر سابق: ص21.
[16] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص322.
[17] المصدر السابق: ص323.
[18] الشيبي، كامل مصطفى، تشيّع وتصوّف، تا آغاز سده دوازدهم هجري [التشيّع والتصوّف، إلى بداية القرن الثاني عشر الهجريّ]، ترجمه بالفارسيّة عليرضا ذكاوتي قراغوزلو، مؤسّسة أمير كبير: طهران، ط1، 1359هـ.ش [1980م]، ص33.
[19] آجند، یعقوب، نمايش در دوره صفوي [العرض المسرحيّ في العصر الصفويّ]، مصدر سابق: ص23.
[20] مقال بقلم إحسان يار شاطر بعنوان (التعزية وطقوس العزاء في إيران قبل الإسلام)، في كتاب: تعزيه، آيين ونمايش در إيران [التعزية، تقاليد العرض المسرحيّ في إيران]، لمؤلّفه تشلكوفسكي، مصدر سابق: ص125.
[21] متز، آدم، تاريخ تمدن إسلامى در قرن جهارم هجرى [الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجريّ]، ترجمه بالفارسیّة محمّد حسين استخر، 1343هـ.ش [1964م]: ص96. وجاء في الترجمة العربيّة لكتاب الحضارة الإسلاميّة في القرن الرابع الهجريّ لادم متز في الفصل الخامس المختصّ بالشيعة ص 125: «وقد ظلّت هذه الصفات عند المسلمين ممّا اختصّ به المسيح× مدّة طويلة، وسرى كثير ممّا كان يقال لاثارة العواطف في يوم جمعة الآلام عند المسيحيّين إلى يوم عاشوراء».
[22] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص327.
[23] صبحي، أحمد محمود، نظريّة الإمامة لدى الشيعة الاثني عشريّة، مصدر سابق: ص340.
[24] الأمين، محسن، المجالس السنية، مصدر سابق: ج1، ص143.
[25] الأمين، محسن، المجالس السنية، مصدر سابق: ج1، ص143.
[26] الشهرستانيّ، السيد صالح، تاريخ النياحة على الإمام الشهيد الحسين بن علي× (مجلّدان) تحقيق وإعداد، الشيخ نبيل رضا علوان، دار الزهراء، بيروت: ص72.
[27] جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، صحابيّ جليل من الأنصار، يكنى أبا عبد اللَّه، وقيل: أبو عبد الرحمن، والأوّل أصح، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي، وقد كان أصغر من شهد العقبة الثانية، وقال بعضهم: شهد بدراً، وقيل: لم يشهدها، وكذلك غزوة أحد. وكان من المكثرين في الحديث، الحافظين للسنن، روى عنه محمّد بن علي بن الحسين، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير المكي، وعطاء، ومجاهد، وغيرهم، كما روى جابر بن عبد الله علماً كثيراً عن النبي| وعن عمر وعلي وأبي بكر وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل والزبير وطائفة، وكان مفتي المدينة في زمانه، شهد ليلة العقبة مع والده، وكان والده من النقباء البدرِيّين، استشهد يوم أحد، وكان جابر قد أطاع أباه يوم أحد، وقعد لأجل أخواته.
[28] السيد بن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف، منشورات بيام عدالت، طهران، ط 5، 1392هـ/2013م: ص272ـ273.
[29] السيد ابن طاوس، اللهوف على قتلى الطفوف، مصدر سابق: ص274.
[30] السيد ابن طاوس، اللهوف على قتلى الطفوف، مصدر سابق: ص276.
[31] تقول الدكتورة عائشة عبد الرحمن، بنت الشاطئ بأنّ زينب بنت عقيل بن أبي طالب أخت هاني هي التي قالت الأبيات التالية. انظر بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، تراجم سيّدات بيت النبوّة، دار الكتاب العربيّ، بيروت، 1404هـ/1984م: ص870.
[32] في البداية والنهاية، مصدر سابق: ج9، ص31: آخر الأمم.
[33] في البداية والنهاية: ج9، ص31، عند منطلقي بدلاً من بعد مفتقدي. (انظر: ابن كثير الدمشقيّ، أبو الفداء الحافظ، البداية والنهاية، وثّقه وحقّقه وقابلَ مخطوطاته: الشيخ عادل معوض، الشيخ عبد الله السيد عبد المنعم، محمّد أحمد بركات، الدكتور صلاح الدين خلدية، مركز الشرق الأوسط الثقافيّ، بيروت: ط1، 1428هـ/ 2008م).
[34] في البداية والنهاية، مصدر سابق، وقتلى بدلاً من ومنهم.
[35] في البداية والنهاية، مصدر سابق: ج11، ص203، بسوء بدلاً من بشر.
[36] ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفّى 597هـ)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دراسة وتحقيق: محمّد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 1412هـ/1992م: ج5، ص342.
[37] بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، تراجم سيدات بيت النبوة، مصدر سابق: ص871.
[38] المصدر السابق.
[39] البرقيّ، أحمد بن محمّد بن خالد، المحاسن، تحقيق وتصحيح وتعليق: السيّد جلال الدين الحسينيّ (المحدّث) دار الكتب الإسلاميّة، طهران، ط1، 1370هـ /1951م: ج 1، ص296.
[40] المجالس السنيّة، مصدر سابق: ج1، ص113.
[41] المصدر السابق.
[42] سبط ابن الجوزي الحنفيّ، يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغداديّ، تذكرة خواص الأمّة في خصائص الأئمّة، منشورات مكتبة نينوى الحديثة، طهران، لا ط.، لا تا: ص240؛ الصواعق المحرقة، ابن حجر، ابي العباس احمد بن محمد بن محمد بن علي: ص297؛ ابن عساكر، الإمام محمّد بن مكرم المعروف بابن منظور (630 ـ711هـ)، مختصر تاريخ دمشق، تحقيق: رومية النحاس، رياض عبد الحميد مراد، محمّد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، ط: 1، 1404هـ/ 1984م: ص63 و65.
[43] الشهرستانيّ، السيد هبة الدين الحسينيّ، نهضة الحسين×، تحقيق مؤسّسة إحياء الكتب الإسلاميّة، دار البلاغ، دار سلوني، بيروت، ط1، 1424هـ/ 2003م: ص147؛ المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار (110 مجلّدات)، منشورات المكتبة الإسلاميّة: طهران، ط3، 1398هـ، ج 45، ص197.
[44] الشهرستانيّ، السيد هبة الدين الحسينيّ، نهضة الحسين×، مصدر سابق: ص147.
[45] الشهرستانيّ، السيد هبة الدين الحسينيّ، نهضة الحسين×، مصدر سابق: ص147.
[46] بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، تراجم سيدات بيت النبوة، مصدر سابق: ص871.
[47] بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، تراجم سيدات بيت النبوة، مصدر سابق.
[48] المصدر السابق: ص872.
[49] المصدر السابق: ص873.
[50] المصدر السابق.
[51] بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، تراجم سيدات بيت النبوة، مصدر سابق: ص873.
[52] المصدر السابق.
[53] الطبريّ، تاريخ الأمم والملوك، مصدر سابق: ج4، ص451.
[54] الشهرستانيّ، تاريخ النياحة علي الحسين، مصدر سابق: ص117.
[55] سيد الأهل، عبد العزيز، زين العابدين (علي بن الحسين)، مكتبة وهبة، القاهرة: ط2، 1961م، ص82.
[56] الأمين، محسن، إقناع اللائم على إقامة المآتم، دار المعارف الإسلاميّة، قم، 1418هـ: ص98.
[57] الأمين، محسن، أعيان الشيعة، حقّقه وأخرجه: حسن الأمين، مطبعة الإنصاف، بيروت، ط1، 1378هـ/1959م: ج4، ص249.
[58] المصدر السابق: ج4، ص249.
[59] الأمين، محسن، أعيان الشيعة، حقّقه وأخرجه: حسن الأمين، مطبعة الإنصاف، بيروت، ط1، 1378هـ/1959م: ج4، ص249.
[60] مغنيّة، محمّد جواد، الشيعة والحاكمون، المصدر السابق: ص126.
[61]ابن قولويه القمّيّ، أبو القاسم جعفر بن محمّد، كامل الزيارات، تحقيق: علي أكبر الغفاريّ، منشورات صدوق، قم، لاتا: ص82.
[62] المصدر السابق: ص81.
[63] الصدوق، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القميّ، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، تحقيق وتقديم: السيد محمّد مهدي السيد حسن الخرسان، مطبعة أمير، قم، ط2، 1368هـ: ص84.
[64] الصدوق، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيّ المتوفّى 381هـ، الأمالي، قسم الدراسات الإسلاميّة، مركز الطباعة والنشر في مؤسّسة البعثة، قم، ط1، 1417هـ: ج2، ص111.
[65] الصدوق، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّيّ المتوفّى 381هـ، الأمالي، مصدر سابق: ج2، ص111.
[66] المصدر السابق: ج5، ص112.
[67] المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق: ج 45، ص257.
[68] الصدوق، عيّون أخبار الرضا، منشورات العلميّه، طهران، لا تا: ج2، ص267؛ مغنيّة، محمّد جواد، الشيعة والحاكمون، مصدر سابق: ص178.
[69] المجلسي، بحار الأنوار، مصدر سابق: ج45، ص258.
[70] الصدوق، الأمالي، مصدر سابق: ج4، ص112.
[71] المصدر السابق: ص60.
[72]الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص327.
[73] راجع دلال عبّاس، بهاء الدين العامليّ أديباً وفقيهاً وعالماً، مصدر سابق، الفصل الأوّل المتعلّق بقيام الدولة الصفويّة.
[74] المستوفي، عبد الله، شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعى وادارى دوره قاجاريه [سيرة حياتي، أو التاريخ الاجتماعيّ والإداريّ في العصر القاجاريّ]، مكتبة محمّد علي علمي، طهران، 1324هـ.ش [1945م]: ج 1، ص376.
[75] نصري أشرفي، جهانغیر، وعبّاس شيرازي آهو دشتي، تاريخ هنر إيران [تاريخ الفنّ الإيرانيّ]، منشورات آرون، طهران، ط1، 1388هـ.ش [2009م]: ج2، ص948.
[76] المصدر السابق.
[77] القمّيّ، عبّاس، الكنى والألقاب (3 أجزاء)، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، قم، ط2، 1429 هـ.ق: ج1، ص155.
[78] الطهرانيّ، الشيخ آغا بزرك، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، (25 مجلداً)، دار الأضواء، بيروت: ج22، ص23ـ24.
[79] عاشورانامه [موسوعة عاشوراء]، مركز الدراسات الاسترتيجيّة والعسكريّة (6 مجلّدات)، منشورات خيمة، قم، ط 1 1388هـ.ش [2009م]: ج4، ص231.
[80] نصري أشرفي، جهانغير، نمايش وموسيقى در إيران [العروض المسرحیّة والموسیقی في إیران]، مصدر سابق: ص123.
[81] رازي، فريدة، نقالى وروحوضى [قراءة شعر الملاحم]، منشورات مركز، طهران، ط1، 1390هـ/ 2011م: ص18.
[82] راجع كتاب النقض المعروف بـ(بعض مثالب النواصب في نقض فضائح الروافض)، من تأليف نصير الدين أبي الرشيد عبد الجليل القزوينيّ الرازيّ، مصدر سابق: ص343.
[83] الثعالبي النيسابوريّ، أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل (المتوفّى 429هـ)، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر(3مجلّدات)، حقّقه وفصّله وضبطه وشرحه: محمّد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، ط2، 1375هـ/1956م: ج3، ص183.
[84] القزوينيّ الرازيّ، النقض، مصدر سابق: ص377.
[85] آجند، يعقوب، نمايش در دوره صفوى [العرض المسرحيّ في العصر الصفويّ]، مصدر سابق: ص33.
[86] المصدر السابق: ص33.
[87] نمايش وموسيقى در إيران [العرض المسرحيّ والموسيقى في إيران]، مصدر سابق: ص92.
[88] ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، مصدر سابق: ج8، ص172.
[89] كامل الزيارات، مصدر سابق: ص100.
[90] الشهرستاني، تاريخ النياحة على الحسين، مصدر سابق: ج2، ص5.
[91] المصدر السابق.
[92] دخيل، علي محمّد علي، أئمتنا، مصدر سابق: ج1، ص478.
[93] المصدر السابق: ج1، ص409.
[94] دخيل، علي محمّد علي، أئمتنا، مصدر سابق: ج2، ص8.
[95] االشهرستاني، تاريخ النياحة على الحسين، مصدر سابق: ج2، ص6.
[96] المصدر السابق.
[97] دخيل، علي محمّد علي، أئمّتنا، مصدر سابق: ج2، ص162.
[98] تاريخ النياحة على الحسين، مصدر سابق: ج2، ص7.
[99] المصدر السابق: ص137.
[100] المصدر السابق.
[101] هو السلطان البويهيّ أبو الحسن أحمد بن بويه الديلميّ، الملقّب بمعزّ الدولة، أوّل من تملّك من سلاطين الدولة البويهيّة وهي دولة شيعيّة أهلها من الديالمة، وبلادهم في الجنوب الغربيّ لبحر قزوين، تسلّطت هذه الدولة على الخلافة العبّاسيّة ابتداءً من عهد الخليفة المطيع لله سنة 334هـ، وهي السنة التي دخل فيها معزّ الدولة أحمد بن بويه بغداد واستلم السلطة الفعليّة في الخلافة، لقد بلغت الحياة الثقافيّة في عهده ذروتها فشملت حقل الآداب بما فيها من نثر وشعر وتطوّرت الدراسات اللغويّة وازدهرت الحياة العقليّة وتكاملت العلوم الفقهيّة وظهرت البحوث في التاريخ والجغرافيا والهندسة والطب وعلم الفلك كما برزت الحركة الصوفيّة والدراسات الدينيّة على مختلف مواضيعها من تفسير القرآن الكريم إلى الدراسات التحليليّة في الأحاديث النبويّة مثلما لجأت المذاهب الإسلاميّة إلى منطق العقل والفلسفة الواقعيّة لتأييد آرائها وبذلك حدثت نهضة علميّة كثرت فيها التصانيف والمناظرات التي أدّت بدورها إلى ظهور مفكّرين روّاد وأساطين المفسرين والفقهاء والشعراء والفلكيّين. اشتغل معزّ الدولة بمحاربة الأمراء المتغلبين على أطراف العراق مثل أمراء الدولة الحمدانيّة، وأبي القاسم البريدي، وغيرهم من الأمراء، وكان معزّ الدولة شيعياً جلداً، ومن أجل ذلك لمّا تحكم في بغداد حاضرة الخلافة أظهر شعائر الرفض وأمر الناس بالاحتفال بيوم كربلاء وبيوم غدير خم، وظهر النوح واللطم ولبس السواد بين الناس، وكان في عهد معزّ الدولة هذا وابتداءً من سنة 352هـ، التشيع عن علم ودراسة وتعمق، واختلف في موعد أو طريقه قتله، وكان معزّ الدولة شجاعاً فقد فَقَدَ يده اليسرى، وقد تصدّق بأموال كثيرة قبل وفاته، في يوم 13 ربيع الأوّل سنة 356هـ وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً. (التنوخي، القاضي أبو علي المحسن بن علي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، تحقيق عبود الشالجي المحامي، (5 أجزاء)، دار صادر، بيروت، ط1، 1391هـ/1971م: ج1، ص138؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، مصدر سابق: ج7، ص 38).
[102] ابن الأثير، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمّد الجزري، الكامل في التاريخ (11 مجلّداً) تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضي، دار الكتب العلميّة، ط1، 1407هـ/ 1987م: ج7، ص203.
[103] تاريخ النياحة علي الحسين، مصدر سابق: ج1، ص147ـ148.
[104] الخليلي، جعفر، موسوعة العتبات المقدّسة، (12 مجلّد)، منشورات مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط2، 1987م: ج1، ص372.
[105] الشهرستانيّ، نهضة الحسين، مصدر سابق: ص160.
[106] تشيد علي أكبر، قهرمانان إسلام [أبطال الإسلام]، (مجلّدان)، ط 1، 1342هـ [1962م]: ص198.
[107] نقدي، الشيخ جعفر بن محمّد (1303ـ1370هـ)، تاريخ الإمامين الكاظمين÷ وروضتهما الشريفة من يوم دفنهما إلى زماننا الحاضر، تحقيق: الشيخ غزوان سهيل الكليدار، الناشر الامانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، دار الرافدين، بيروت، ط 1، 1435هـ/2014م: ص55.
[108] فيض، ميرزا عباس، تاريخ كاظمين، (مجلّدان)، قم، 1327هـ.ش [1948م]: ص84.
[109] ابن الأثير، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمّد الجزري، الكامل في التاريخ، مصدر سابق: ج9، ص286.
[110] ميرخواند، محمّد بن خاوند شاه بن محمود، تاريخ روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفا، تصحيح: جمشيد كيان فر، منشورات أساطير، طهران، ط1، 1380هـ.ش [2001م]: ص2987ـ2988.
[111] مايل بكتاش، مقال بعنوان (تعزية وفلسفهء آن) [التعزیه وفلسفتها]، منشور في كتاب تعزيه، هنر بومى پيشرو إيران [عروض التعزیة، الفنّ المحليّ الطليعيّ الإيرانيّ]، لمؤلّفه تشلكوفسكي، بيتر، تعزيه، هنر بومى پيشرو إيران [عروض التعزية، الفنّ المحلّيّ الطليعي الإيرانيّ]، ترجمه بالفارسيّة داود حاتمي، منشورات الشركة العلميّة والثقافيّة للنشر، طهران، ط 1، 1367هـ.ش [1988م]: ص142.
[112] منیمنة، حسن، تاريخ الدولة البويهيّة، الدار الجامعيّة، بيروت، 1407هـ/ 1987م: ص282.
[113] نهضة الحسين×، مصدر سابق: ص215.
[114] الكليدار، آل طعمة، عبد الحسين، بغية النبلاء في تاريخ كربلاء، مطبعة الإرشاد، بغداد، لا تا: ص154.
[115] المفيد، الأمالي: ص94.
[116] الناشئ أو الناشئ الصغير، هو علي بن عبد الله بن وصيف، أبو الحسن، المولود سنة 271هـ والمتوفّى في العام 365هـ والمدفون في مقابر قريش في الكاظمين وكان يعمل الصفر ويخرمه، وله فيه صنعة بديعة، وكان شاعراً يمدح أهل البيت فسمّي شاعر أهل البيت. وله قصيدة في رثاء الحسين: مطلعها: رجائي بعيد والممات قريب ويخطئ ظنّي والمنون تعيب (الشهرستانيّ، تاريخ النياحة على الحسين، مصدر سابق: ج2، ص17).
[117] كان البربهاري رئيس الحنابلة وكان يدفعهم إلى كثير من أعمال العنف، فأخذوا يكبسون الدُّور، ويتعرضون البيع والشراء، وأرهبوا كلّ من لا يرى رأيهم، حتى إنّ الإمام الطبريّE، صاحب التفسير والتاريخ، ظلّ حبيس داره مدّة، ولما توفّي حالوا دون تشييعه ودفنه، وزاد شرهم وفتنتهم، واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون إلى المساجد فاذا مرّ بهم شافعي المذهب، أغروا به العميان فضربوه بعصيهم، حتى يكاد يموت، الأمر الذي اضطر الخليفة أن يصدر بشأنهم منشوراً، قال فيه: إنّ من نافق بإظهار الدين، وتوثّب علي المسلمين، وأكل به أموال المعاهدين، كان قريباً من سخط ربّ العالمين، وغضب الله، وهو من الضالين. وقد مات البربهاري سنة 329 وهو ابن 96 سنة (نشوار المحاضرة، مصدر سابق: ج2، ص233؛ ابن مسكویه، أبو علي الرازيّ، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، حقّقه وقدّم له الدكتور أبو القاسم إمامي، (7 أجزاء) دار سروش للطباعة والنشر، طهران، 1379هـ.ش [2000م]: ج 1، ص322؛ ابن الأثير، عزّ الدين أبو الحسن علي بن محمّد الجزري، الكامل في التاريخ، مصدر سابق: ج 8، ص307؛ الحمَويّ الروميّ البغداديّ، أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله، معجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (7 مجلّدات)، تحقيق: الدكتور إحسان عبّاس، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط1، 1993م: ج 6، ص436).
[118] التنوخي، نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، مصدر سابق: ج2، ص232.
[119] المصدر السابق: ج2، ص133.
[120] القزويني الرازيّ، نصير الدين أبو الرشيد عبد الجليل، النقض المعروف بـ(بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض)، القرن السادس، تصحيح: مير جلال الدين محدّث، سلسلة منشورات الجمعیة الوطنیّة للآثار، طهران، 1385هـ.ش [2006م]: ص370ـ371.
[121] القزويني الرازيّ، نصير الدين أبو الرشيد عبد الجليل، النقض المعروف بـ(بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض)، مصدر سابق: ص371 ـ373.
[122] المصدر السابق: ص372.
[123] المصدر السابق: 102، ص372.
[124] المصدر السابق.
[125] غازان خان المعروف بالسلطان محمود غازان خان من أشهر وأقدر السلاطين الإيلخانيّين المغول الذين حكموا إيران وهو سابع حاكم إيلخانيّ حكم إيران. تولّى السلطة في الثالث والعشرين من ذي القعدة 694هـ/ الرابع من ت1/أكتوبر 1295م بعد وفاة أبيه أرغون وبعد مقتل كيخاتو وبايدو إثر القتال بينهم ووصل إلى مدينة تبريز. كان يدين بالبوذيّة ولكنّه أسلم بتشجيع من أمير نوروز. وأصدر أمراً بتخريب كنائس المسيحيّين ومعابد البوذيّين وكنيست اليهود في تبريز وبغداد (تاريخ إيران كمبريج، جمعه جي. أ. تريل، ترجمة: حسن أنوشه، منشورات أمير كبير، طهران، ط: 5، 1381هـ.ش [2002م]: ج 5، ص356ـ357).
ولد غازان خان في 29 ربيع الثاني 650هـ/11 نوفمبر 1271م، في جزيرة ابسكون الواقعة في مازندران (شمال إيران الحاليّة) وتولّى الحكم في العام 694هـ في مدينة تبريز الإيرانيّة وأعلن يوم تولّيه الحكم الإسلام دين الدولة وأمر بتخريب كلّ المعابد والأصنام وغير الكنائس إلى مساجد. توفّي غازان خان يوم الجمعه 11 شوال 703هـ /5 مايو ـ أيار 1304م، في مدينة قزوين ودفن في مدينة تبريز (مقال: بعنوان (إسلام غازان خان وتأثیر وتداعیات ذلك علی سائر الأدیان والمذاهب في إیران)، المنشور في مجلة پژوهشنامه تاریخ [بحوث تاریخیّة]، السنة الثالثة، العدد 12، طهران).
[126] المصدر السابق: ص377.
[127] السلطان محمّد خدابنده (أي عبد الله).
أولجايتو هو الحاكم الثامن من الحكام الإيلخانيّين المغول الذي خلف والده غازان خان سنة 703هـ وكان أولجايتو قد ولد سنة 1280م وتوفّي في 16 ك1 ـ ديسمبر 1316م في سلطانية. وكان أولجايتو مسيحيّاً في طفولته وقبل البوذيّة ولكنّه اعتنق الدين الإسلاميّ وسار على مبادئ المذهب الحنفيّ ولكنّه تشيّع بعدما زار مدينة النجف في شتاء 709 هـ/ 1310م وعلي إثر تلاسن بين اثنين من فقهاء المذهبين الحنفيّ والشافعيّ وبعد مناظرة جرت بين العلّامة الحليّ أحد العلماء الشيعة ونظام الدين مراغه أي، توفّي أولجايتو في الثامن والعشرين من رمضان سنة 716هـ /17 ك1 ـ ديسمبر سنة 1316م. وهو في السادسة والثلاثين من عمره ودفن في سلطانية (تاريخ إيران كمبريج، مصدر سابق: ج 5، ص373ـ381).
[128] القزوينيّ الرازيّ، عبد الجليل، النقض، مصدر سابق: ص373.
[129] الشهرستاني، تاريخ النياحة على الحسين، مصدر سابق: ص23.
[130] المصدر السابق: ص24.
[131] الشهرستاني، تاريخ النياحة على الحسين، مصدر سابق: ص24.
[132] شمس الدين، محمّد مهدي، ثورة الحسين، مصدر سابق: ص39.
[133] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص 62ـ63.
[134] داود باشا (1188 ـ 1267هـ/ 1767 ـ 1851م) والي بغداد. هو آخر ولاة المماليك الذين حكموا مدينة بغداد. ولد داود في تبليسي في جورجيا، وبيع في بغداد مملوكاً، ثم اعتنق دين الإسلام. تعرف على الوالي سليمان باشا، حيث تزوج من ابنته، وتدرّج في أرقى المناصب في زمانه، ومن ثم أصبح والياً على بغداد بعد وفاة سليمان باشا، فاشتهر عنه غزواته للعشائر المتمرّدة في لواء الدليم، كما اشتهر عنه بسالته ودفاعه في مواجهة الإيرانيّين (علي الوردي، لمحات اجتماعيّة من تاريخ العراق الحديث، منشورات الشريف الرضي، قم، إيران: ط1، ج1، ص237ـ238.
[135] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص63ـ64.
[136] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص66ـ67.
[137] المصدر السابق: ص66.
[138] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص66ـ67.
[139] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص66ـ81.
[140] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص 71ـ81.
[141] جميلي، عبّاس خدوم، تعزيه در عراق و چند كشور إسلامی [التعزية في العراق وفي عدد من البلدان الإسلامیّة]، ترجمة مجيد سرسنكي، منشورات: أكاديميّة الفنّ، ط1، 1385هـ.ش [2006م]: ص47.
[142] التطبير أو الإدماء هو شعيرة شعبيّة عند المسلمين الشيعة الاثني عشريّة ـ بعضٌ منهم يرفضونها ـ ضمن الشعائر المسماة بالشعائر الحسينيّة التي تقام من أجل استذكار معركة كربلاء والقتلى الذين قتلوا في هذه المعركة كالإمام الحسين بن علي وأخيه العبّاس. ويستخدم في التطبير سيوف وقامات أو أي أدوات حادّة أخرى، فيضرب المطبّرون رؤوسهم بهذه الأدوات لإحداث جرح لإسالة الدماء منه، ويردّد المطبرون اثناء التطبير كلمة (حيدر) والتي تشير إلى الإمام علي بن أبي طالب الذي توفي بسبب ضربة سيف وجهها إليه عبد الرحمن بن ملجم وهو يصلّي. ولفظة (التطبير) لفظة عامية تُستخدم في العراق وما جاوره من عرب الجزيرة الشمالية والجنوبية والخليج والأهواز، فيقولون طبر الخشبة أو العظم بالطبر (الفأس أو القدوم أو الساطور في الشام) ويقصدون الضرب بالساطور وغيره من الأدوات الحادة، ويرى البعض أن للّفظ أصول تركية أو بابلية لأن طَبَرَ في العربيّة الفصحى لا تصح إلّا بمعنى قفز واختبأ. يُعرف التطبير باللهجة البحرانيّة المنتشرة في البحرين والقطيف باسم (الحيدر) إشارة لكلمة حيدر التي يردّدها المطبرون، وحيدر هو أحد أسماء علي بن أبي طالب، كما يسمى التطبير (بالفارسية قمه زني). في باكستان والهند يُعرف التطبير بعدة أسماء منها (قمه زنی) و(تلوار زنی). ومن الشعائر الحسينية التي تقع ضمن دائرة شعائر الإدماء هي شعيرة إدماء الظهر بسلسلة خفيفة من السكاكين، وهذه الشعيرة شعيرة مستقلة وليست من التطبير، وقد وقع الخلاف فيها كما وقع على التطبير، وممارسة هذه الشعيرة رائجٌ عند الشيعة في باكستان والهند بشكل أوسع من باقي البلدان (الموسوعة الحرّة، كلمة تطبير).
تختلف الآراء حول كيفية ظهور التطبير ومن كان الأوّل من أشاع التطبير في العالم الإسلاميّ وانتشاره في عدد من البلدان الإسلاميّة وخاصة في العراق ولبنان وتمنعه الحكومة الإيرانيّة حاليّاً، وترى بأنه يشوه سمعة الشيعة في العالم. وهناك روايات متعدّدة تتناقلها الكتب ومنها أنّ التطبير مقتبس عن أرثوذكس القوقاز أو أنّه ظهر في الدولة الصفويّة (1501ـ1722م) أو في العهد الناصريّ أي عهد ناصر الدين شاه (1848ـ1897م)، وكان هذا الطقس يمارس في هذا العصر حسب الكاتب عبد الله المستوفي في كتابه بالفارسيّة: شرح زندكاني من يا تاريخ اجتماعيّ واداري دوره قاجاريه [سيرة حياتي او التاريخ الاجتماعيّ والإداريّ في العصر القاجاريّ]، مصدر سابق: ج1، ص 276. إذ إنّه يعدّ فاضل الدربنديّ هو الذي أدخل التطبير في طقوس عاشوراء. ثمّة رواية أخرى تفيد أنّ الشيعة من أتراك أذربيجان وتبريز وقفقاسيّة قدموا العراق لزيارة العتبات المقدّسة وذلك في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر الميلاديّ، فدخل جماعة منهم في العاشر من محرم الحرام إلى صحن الحسين× واجتمعوا قرب الباب المعروف اليوم بالزينبيّة ومعهم القامات وهو سلاحهم التقليديّ الذي يلازمهم خلال سفرهم.
ثم أقاموا مجلساً للتعزية في المكان المذكور وأخذ مقرؤهم يشرح لهم واقعة الطفّ باللغة التركيّة بشكل أهاج مشاعرهم فاخرجوا قاماتهم وأخذوا يضربون رؤوسهم دون أن يحلقوها وبشكل عنيف، حول صخرة بارزة في المكان المذكور. وقد توفّي اثنا عشر شخصاً من هؤلاء الأتراك بعد عمليّة التطبير المذكورة مباشرة، حيث لم تسعفهم الجهات الصحيّة في حينه، لأنّها لم تتوقّع إقدامهم على مثل هذا العمل، ولم تتهيّأ له. وينقل أيضاً أحمد العامري الناصريّ في كتابه التطبير تاريخه وقصصه (ص45)، نقلاً عن كتاب (الأيام في كربلاء) لمحسن العلام، قصّة القائد التركيّ الذي لم يصل في الوقت المناسب لحضور مراسم الشعائر الحسينيّة في كربلاء ووصل بعد انتهاء تلك المراسم فقام بضرب رأسه بالسيف ندماً أمام جنوده حتى قضى، فصار جنوده يأتون كلّ عام وهم يحملون السيوف ويضربون بها رؤوسهم وفاءً لذلك القائد، فاستحسن الناس هذا الفعل وقاموا بتقليده ومنه نشأ التطبير.
(راجع مقال التطبير بين الشعائرية والتحريم ـ متى ظهر التطبير؟ رشيد السراي في موقع مؤسّسة النور للثقافة والإعلام بتاريخ 12ـ2ـ2011م): http: //www.alnoor.se/article .
[143] ولد في بلدة شقراء (جنوب لبنان) في العام 1284 للهجرة أي في حدود العام 1867 للميلاد. وهو ذو نسب شريف ينتهي إلى الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. درس العلوم الدينيّة في جامعة النجف ثمّ تخرج فيها وطلب دمشق ليكون إماماً للشيعة في سوريا ومفتيا لهم (حلقة دراسيّة حول عاشوراء، تأليف مجموعة من الكتّاب، بيروت: 1974، ص20).
[144] ولد في مدينة النجف في العراق سنة 1279 للهجرة أي حدود العام 1862 للميلاد وترعرع في بلدة الخيام في أقصى جنوب لبنان منذ سنته الخامسة ثمّ درس العلوم الدينيّة في جامعة النجف.كان أبوه شاعراً مجيداً، كما أنّه أبٌ لرجال دين وشعراء مجيدين (حلقة دراسيّة حول عاشوراء، مصدر سابق: ص20).
[145] حلقة دراسيّة حول عاشوراء، مصدر سابق: ص26.
[146] حلقة دراسيّة حول عاشوراء، مصدر سابق: ص27.
[147] عبد الحسين صادق، سيماء الصلحاء، طبع في مطبعة العرفان، صيدا، سنة 1345هـ /1927م، يقع في 82 صفحة من القطع الوسط.
[148] حلقة دراسيّة حول عاشوراء، مصدر سابق: ص45.
[149] حلقة دراسيّة حول عاشوراء، مصدر سابق: ص37.
[150] المصدر السابق: ص37.
[151] المصدر السابق: ص45.
[152] معتمدي، سيد حسين، عزادارى سنتى شيعيان در بيوت علما وحوزه هاى علميه وكشورهاى جهان [العزاء التقليديّ في بيوت العلماء والحوزات وبلدان العالم]، منشورات عصر ظهور، ط1، 1378هـ.ش [1999م]: ص299.
[153] السيّد حسن الشيرازيّ، الشعائر الحسينيّة، دار الصادق، بيروت 1384هـ: ص43.
[154] وهذا أيضاً ما يجري في النبطيّة، ومعظم القرى اللبنانيّة ذات الأغلبيّة الشيعيّة (الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص96ـ97).
[155] من أشهر كتب المقاتل التي يستند إليها قراء المجالس الحسينيّة هو كتاب (مقاتل الطالبيّين) لأبي الفرج الإصفهانيّ ومقتل أبي مخنف و(مقتل الحسين) لعبد الرزّاق المقرم، و(المجالس السنيّة) للسيد محسن الأمين العامليّ وغيرها، التي تصف وتصوّر جميع الأحداث والمعارك والخطب والأقوال والمواقف المتميّزة التي حدثت في كربلاء، كالشجاعة والبطولة والتضحية والإباء التي تميّز أهل البيت وأنصارهم، وكذلك ما لاقوه من ظلم وآلام.
[156] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص97.
[157] المصدر السابق: ص364.
[158] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص411.
[159] الحيدري، إبراهيم، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص68.
[160]المعلومات المدرجة في هذا المقال كتبها الباحث حسبما رآها في المدن العراقيّة المقدّسة وخاصّة مدينة كربلاء مسقط رأسه خلال أيام شهر محرم.
[161] مقال بقلم : انعام كاطع موقع وزارة الثقافة العراقية: http: //crd.gov.iq/pgDetails.aspx?NID.
[162] المجلسيّ، محمّد باقر، بحار الأنوار، مصدر سابق: ج 45، ص60.
[163] شريف القرشي، باقر، حياة الإمام الحسين بن علي، مصدر سابق: ج 3، ص298.
[164] www.iraqcenter.net.
[165]تراجيديا تشابيه حرق الخيام الحسينية في العاشر من محرم الحرام: http: //www.iraqkhair.com.
[166] قبائل بني اسد في كربلاء، ارث الاحياء الحسيني في الثالث عشر، المسلة 10/3/2016: http://almasalah.com/ar/news/41045.
[167] الراعي، علي، المسرح في الوطن العربيّ، المجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1410هـ/ 1990م: ص213ـ214.
[168]الراعي، علي، المسرح في الوطن العربيّ: ص213ـ214.
[169] رؤية في مسرح التعزية، عبد الخالق كيطان، ملحق حريدة المدى العراقية، 20/10/2015.
[170] المصدر السابق.
[171] رؤية في مسرح التعزية، عبد الخالق كيطان، ملحق حريدة المدي العراقية، 20/10/2015.
[172] رؤية في مسرح التعزية، عبد الخالق كيطان، ملحق حريدة المدي العراقية، 20/10/2015.
[173] المصدر السابق: ص236.
[174] رؤية في مسرح التعزية، عبد الخالق كيطان، ملحق حريدة المدي العراقية، 20/10/2015
[175] الراعي، علي، المسرح في الوطن العربيّ.
[176] مقال بقلم إبراهيم حاج عبدي: تعريفاً بكتاب مسرح التعزية في العراق، بقلم الدكتور مناضل داود.
http: //www.albayan.ae/paths/books.
[177] مقال (فصول من تاريخ المسرح العراقي.كربلاء وتشابيه المقتل والتعازي الحسينية في عاشوراء) بقلم: لطيف حسن: http: //al-nnas.com.
[178] إبراهيم الحيدري، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص163.
[179] إبراهيم الحيدري، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق.
[180] خدوم جمیلي، عبّاس، تعزيه در عراق وچند کشور عربی [التعزية في العراق وعدّة دول عربيّة]، مصدر سابق: ص67.
[181] إبراهيم الحيدريّ، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص164.
[182] جعفریان، رسول، أطلس شيعه [أطلس الشيعة]، منشورات: المديريّة الجغرافيّة للقوّات المسلّحة (إيران)، ط1، 1387هـ.ش [1998م]: ص240.
[183] بني المسجد في عهد الفاطميّين سنة 549 هـ/1154م تحت إشراف الوزير الصالح طلائع.
[184] إبراهيم الحيدريّ، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص173.
[185] المصدر السابق.
[186] إبراهيم الحيدريّ، تراجيديا كربلاء، مصدر سابق: ص173ـ174.
[187] المقريزي، الشيخ الإمام تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد، الخطط المقريزيّة، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، منشورات دار إحياء العلوم، ومنشورات مكتبة العرفان، بیروت: ج2، ص 289.
[188] مغنيّة، محمّد جواد، الشيعة والتشيّع، مكتبة المدرسة ودار الكتب اللبناني، بيروت، منشورات شريف الرضي، قم، ط 2، 1405هـ: ص175.
[189] المصدر السابق: ص174.
[190] راجع موقع مركز الأبحاث العقائديّة، (الشيعة في البحرين http: //www.aqaed.com).
[191] راجع موقع مركز الأبحاث العقائديّة، (الشيعة في السعودية http: //www.aqaed.com).
[192] راجع موقع مركز الأبحاث العقائديّة، (الشيعة في الكويت http: //www.aqaed.com).
[193] راجع موقع مركز الأبحاث العقائديّة، (الشيعة في الامارات http: //www.aqaed.com).
[194] مركز الأبحاث العقائديّة، (الشيعة في قطر) http: //www.aqaed.com ؛ رسول جعفريان، أطلس الشيعة، مصدر سابق: ص243.
[195] (راجع مركز الأبحاث العقائديّة): http: //www.aqaed.com.
[196] الحج: آية32.
[197]الشورى: آية23.
[198] علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. ولد في المدينة المنورة يوم الجمعة 5 شعبان سنة 38هـ واشتهر بزين العابدين وسيّد الساجدين وسيّد العابدين والزكي والأمين وذي الثفنات. وهو الإمام الرابع عند الشيعة. أمّه شاه زنان بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى ملك الفرس وقيل شهربانو. شهد واقعة كربلاء وواكب مسيرة العائلة إلى الكوفة ومنها إلى الشام. توفّي في الخامس والعشرين من محرم سنة 95 للهجرة (أئمّتنا، علي محمّد علي الدخيل، مصدر سابق: ص268).
[199] القمّيّ، أبو الحسن علي بن إبراهيم، من أعلام القرنين 3 و4هـ، تفسير القمّيّ، صحّحه وعلّق عليه وقدّم له: حجّة الإسلام العلّامة السيد طيب الموسويّ الجزائريّ، منشورات مكتبة الهدى، مطبعة النجف، جزءان، 1387هـ: ص616.
[200] الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق الإمام السادس عند الشيعة ومؤسّس المذهب الجعفريّ الاثني عشريّ وهو ابن الإمام محمّد الباقر. ولد في المدينة المنورة يوم الجمعة او الاثنين عند طلوع الفجر في السابع من ربيع الأوّل سنة 80هـ أو 83 هـ. توفّي في الخامس والعشرين من شوال 148هـ في المدينة المنورة (أئمّتنا، علي محمّد علي الدخيل، مصدر سابق: ص407).
[201] الشيرازيّ، السيد حسن، الشعائر الحسينيّة، مصدر سابق: ص44.
[202] مطهري، مرتضى، خدمات متقابل إسلام وإيران [الخدمات المتبادلة بین الإسلام وایران]، منشورات مكتب المنشورات الإسلاميّ، قم، ط2، 1360هـ.ش [1981م]: ج2، ص18.
[203] جعفريان، رسول، تاريخ تشيع از آغاز تا قرن هفتم هجرى [تاریخ التشیع من البداية وحتی القرن السابع الهجريّ]، منشورات مؤسّسة التبليغ الإسلاميّ، طهران، ط5، 1377هـ.ش [1998م]: ص47.
[204] صبحي، أحمد محمود، نظريّة الإمامة لدى الشيعة الاثني عشريّة، مصدر سابق: ص355.
[205] جعفريان، رسول، تاريخ تشيع از آغاز تا قرن هفتم هجرى [تاریخ التشیع من البداية وحتی القرن السابع الهجريّ]، مصدر سابق: ص71.
[206] المستوفي، حمد الله، نزهة القلوب، تصحيح: الدكتور محمّد دبير سياقي، منشورات حديث اليوم، ط1، 1381هـ.ش [2002م]: ص70ـ130.
[207] جعفريان، رسول، تاريخ تشيع از آغاز تا قرن هفتم هجرى [تاريخ التشيّع من البداية حتّى القرن السابع الهجريّ]، مصدر سابق: ص153.
[208] إقبال، زهرا، مقال بعنوان: مرثيه سرايي در عهد قاجار [الرثاء في العصر القاجاري] في كتاب تعزيه: آيين ونمايش در إيران [التعزية: العروض المسرحيّة في إيران]، لمؤلّفه تشلكوفسكي، بيتر، ترجمه بالفارسيّة داود حاتمي، منشورات مؤسّسة دراسة وتدوين كتب العلوم الإنسانيّة في الجامعات (سمت)، ط 2، 1389هـ.ش [2010م]: ص275.
[209] وتسمّى كذلك (شهربانويه) و(شاه زنان). وهي بنت يزدجرد آخر ملوك الفرس، أسرها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب وبعثوا بها إلى المدينة المنورة مع سائر من سبي من بلاد فارس، وأطلقوا سراحها، خطبها جماعة من العرب، فأختارت من بينهم الحسين بن علي×، وهي أم علي بن الحسين المشهور بالسجاد، ولهذا السبب يعتقد الإيرانيّون ان لهم صلة قربى مع أهل بيت الرسول| (محدثي، جواد، موسوعة عاشوراء، مركز الدراسات الاسترتيجيّة والعسكريّة (6 مجلّدات)، منشورات خيمة، قم، ط 1 1388هـ.ش [2009م]: ص272ـ273).
[210] مظلوم زاده، محمّد مهدي، سير تعزيه در كازرون [المسار التاریخي للتعزية فی کازرون]، منشورات مركز البحوث والدراسات والتقويم لبرامج الإذاعة والتلفاز في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، طهران، ط1، 1382هـ.ش [2003م]: ص3.
[[211]) التعليق للدكتورة دلال عبّاس.
[212] سلمان الفارسيّ أو سلمان المحمّديّ (… ـ 36هـ / … ـ 656م)، واسمه عندما كان ببلاد فارس روزبه وقيل (مابه بن يوذخشان) وأصله من منطقة إصبهان في إيران، هو صحابي دخل الإسلام بعد بحثٍ وتقصٍّ عن الحقيقة، وكان أحد المميّزين في بلاد فارس بلده الأصليّ. دان بالمجوسيّة ولم يقتنع بها، وترك بلده فارس فرحل إلى الشام والتقى بالرهبان والقساوسة ولكنّ أفكارهم ودياناتهم لم تقنعه. واستمرّ متنقّلاً حتى وصل إلى الجزيرة العربيّة فالمدينة والتقى محمّد بن عبد الله| فاعتنق الإسلام وهو الذي أشار على النبي محمّد| في غزوة الخندق أن يحفروا حول المدينة المنوّرة خندقاً يحميهم من قريش، وذلك لما له من خبرة ومعرفة بفنون الحرب والقتال لدى الفرس. ويُعتقد أنّه مدفون في بلدة المدائن قرب بغداد.
[213] مظلوم زاده، محمّد مهدي، سير تعزيه در كازرون [المسار التاريخيّ للتعزية في كازرون]، المصدر السابق: ص3.
[214] البِيرونيّ، أبو الرَّيحان محمّد بن أحمد (973ـ1048هـ)، الآثار الباقية من القرون الخالية، الناشر: مكتبة الثقافة الدينيّة، القاهرة، ط1، 1428هـ/ 2008م: ص321.
[215] مدينة سيستان تقع في شمال شرقي إيران وتعدّ إحدى المحافظات الإيرانيّة المجاورة لباكستان.
[216] باستاني باريزي، محمّد إبراهيم، مار در بتكده كهنه [أفعی في معبد قدیم]، منشورات العلم، ط2، 1369هـ.ش [1990م]: ص326.
[217] المصدر السابق: ص327.
[218] المصدر السابق.
[219] بيضائي، بهرام، نمايش در إيران [العرض المسرحيّ في إیران]، منشورات المثقّفين والدراسات النسائيّة، طهران، ط8، 1391هـ.ش [2012م]: ص56؛ معتمدي، سيد حسين، عزادارى سنتى شيعيان در بيوت علماء وحوزه هاى علميه و كشورهاى جهان [التعزية التقليديّة للشيعة في بيوت العلماء والحوزات العلميّة ودول العالم]، منشورات عصر ظهور، ط1، 1378هـ.ش [1999م]: ص42.
[220] بيضائي، بهرام، نمايش در إيران [العرض المسرحيّ في إیران]، منشورات المثقّفين والدراسات النسائيّة، طهران، ط8، 1391هـ.ش [2012م]: ص56.
[221] القزوينيّ الرازيّ، عبد الجليل، النقض، مصدر سابق: ص372.
[222] الحَمَوي، ياقوت، معجم البلدان، مصدر سابق: ج7، ص13.
[223] سفرنامه ابن بطوطه [رحلة ابن بطوطة]، ترجمة : محمد علي موحد، منشورات علمي فرهنكي، ط1، 1361هـ.ش [1982م]: ج1، ص497.
[224] سفرنامه ابن بطوطه [رحلة ابن بطوطة].
[225] شكّل السادة المرعشيّون حكومة شيعيّة في طبرستان في مازندران في القرن الثامن الهجريّ.
[226] شكّل آل كيا الشيعة حكومة في جيلان في القرن الثامن للهجرة واستمرّت حكومتهم أكثر من مائتي عام.
[227] تشلكوفسكي، بيتر، تعزيه: آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص335.
[228] الشاه إسماعيل الصفويّ هو أبو المظفر بن الشیخ حیدر بن الشیخ جنید المعروف بشاه إسماعیل الأوّل مؤسّس السلسلة الصفویّة. حكم الشاه إسماعيل إيران من سنة 907 إلى 930هـ/1501ـ1524م.
[229] آجند، يعقوب، نمايش در دوران صفوی [العرض المسرحيّ في العهد الصفويّ]، منشورات مؤسّسة التأليف والترجمة والنشر للآثار الفنّيّة، طهران، ط2، 1388هـ.ش [2009م]: ص38.
[230] خواندمير، غياث الدين محمد بن همام، حبيب السير في أخبار أفراد البشر، بإشراف محمد دبير سياقي، منشورات أساطير، 1363 هـ.ش [1984م]: ص65ـ66.
[231] عبّاس، دلال، بهاء الدين العامليّ، أديباً وفقيهاً وعالماً، دار الحوار، بيروت 1995، دار المؤرّخ العربيّ، 2010: ص61.
[232] الشاه إسماعيل الصفويّ هو أبو المظفر بن الشیخ حیدر بن الشیخ جنید المعروف بشاه إسماعیل الأوّل مؤسّس السلسلة الصفویّة. حكم الشاه إسماعيل إيران من سنة 907 إلى 930هـ/1501ـ1524م.
[233] آجند، يعقوب، نمايش در دوران صفوی [العرض المسرحيّ في العهد الصفويّ]، مصدر سابق: ص39ـ41.
[234] فلسفي، نصر الله، زندگانى شاه عبّاس اول [حياة الشاه عبّاس الأوّل]، منشورات محمّد علي العلمي، طهران، 1369هـ.ش [1990م]: ج 3، ص13؛ عبّاس، دلال، بهاء الدين العامليّ أديباً وفقيهاً وعالما، مصدر سابق: ص149.
[235] تاريخ إيران كمبريدج، مصدر سابق: ج1، ص545.
[236] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آيينى [قراءة التعزیة، حدیث المصائب القدسیّة في التمثیل الدینيّ]، منشورات أمير كبير، طهران، ط1، 1383هـ.ش [2004م]: ص93.
[237] المصدر السابق.
[238] مقال: عزادارى إيرانيان بر شهيدان كربلا در دوره صفويه وقاجاريه [عزاء الإيرانيّين على شهداء كربلاء في العهدين الصفويّ والقاجاريّ] في صحيفة جام جم الإيرانيّة بتاريخ 16 اسفند 1381[16 آذار ـ مارس 2003م].
[239] بيترو ديلا فاله من أشهر السيّاح الأوروبيّين. زار إيران في العصر الصفويّ. ولد بيترو ديلا فاله سنة 1586 في روما وبدأ منذ العام 1614 زياراته للشرق، فقد زار القسطنطينيّة وآسيا الصغرى، ومصر والقدس ودمشق وحلب وبغداد، وزار إيران في العام 1617 وأقام 6 سنوات فيها، كما زار الهند وأقام فيها حوالى عامين، وعاد إلى ايطاليا بعد اثني عشر عاماً من التجوال (دانش بجوه، منوجهر، بررسى سفرنامه هاى دوره [دراسة كتب الرحلات في العصر الصفويّ]، منشورات مجمع الفنّ في إصفهان، ط1، 1382هـ.ش [2003م]: ص115. يتضمن كتاب بيترو دلا فاله الذي رافق الشاه عبّاس الصفويّ في بعض رحلاته نقاطاً جيّدة منها تاريخ العصر الصفويّ والوضع الإداري والاجتماعيّ في عصر الشاه عبّاس. وأجرى المؤلّف في كتابه مقارنة بين إيران في العصر الصفويّ والدولة العثمانيّة وصرح بأفضلية إيران (زرين كوب، عبد الحسين، تاريخ إيران بعد از إسلام [تاريخ إيران بعد الإسلام]، منشورات أمير كبير، طهران، ط 15، 1392هـ.ش [2013م]: ص104).
[240] سفرنامه بيترو ديلا واله [رحلة بيترو ديلا فاله]، ترجمه بالفارسيّة شجاع الدين شفا، منشورات: الشركة العلميّة والثقافيّة للنشر، طهران، 1370هـ.ش [1991م]: ص100، 102.
[241] المصدر السابق.
[242] المصدر السابق.
[243] سفرنامه بيترو ديلا واله [رحلة بيترو ديلا فاله]، ترجمه بالفارسيّة شجاع الدين شفا، منشورات: الشركة العلميّة والثقافيّة للنشر، طهران، 1370هـ.ش [1991م]: ص100، 102.
[244] نيازمند، رضا، شيعه در تاريخ إيران [الشیعة فی تاریخ إیران]، مصدر سابق: ص150.
[245] إسکندر منشي، تاريخ عالم آرای عبّاسی [تاريخ العالم في عصر الشاه عبّاس الصفويّ]، تصحيح: محمّد إسماعيل رضواني، (3 مجلّدات) منشورات: دنيا الكتاب، ط1، 1377هـ.ش [1998م]: ج2، ص820.
[246] المصدر السابق.
[247] المصدر السابق.
[248] إسکندر منشي، تاريخ عالم آرای عبّاسی [تاريخ العالم في عصر الشاه عبّاس الصفويّ]، تصحيح: محمّد إسماعيل رضواني، (3 مجلّدات) منشورات: دنيا الكتاب، ط1، 1377هـ.ش [1998م]: ج2، ص820.
[249] آجند، يعقوب، نمايش در دوران صفوی [العرض المسرحیّ في العصر الصفويّ]، مصدر سابق: ص45.
[250] آدام اولئاريوس، كان سكرتيراً لوفد ألمانيّ زار إيران في العهد الصفويّ من أجل إقامة علاقات تجاريّة مع الدولة الصفويّة. كان أولئاريوس يتقن التركيّة والفارسيّة وأقام لمدّة عام ونصف في إيران. وكتب أولئاريوس كتاباً عن رحلته إلى إيران، طبع الكتاب سنة 1656م (دانش بجوه، منوجهر، بررسى سفرنامه هاى دوره صفوى [دراسة مدونات الرحلات في العصر الصفويّ]، مصدر سابق: ص181ـ215).
[251] أولئاريوس، آدم، اصفهان خونين شاه صفى، سفرنامه [الرحلة إلى إصفهان الدامية في عهد شاه صفي]، ترجمه بالفارسيّة مهندس حسين كردبجه، منشورات هيرمند، طهران، 1379هـ.ش [2000م]: ج2، ص487، 489.
[252] أولئاريوس، آدم، اصفهان خونين شاه صفى، سفرنامه [الرحلة إلى إصفهان الدامية في عهد شاه صفي]، ترجمه بالفارسيّة مهندس حسين كردبجه، منشورات هيرمند، طهران، 1379هـ.ش [2000م]: ج2، ص487ـ489.
[253] المصدر السابق: ص45ـ46.
[254] جان باتيست تافرنيه سائح وتاجر فرنسي ولد سنة 1605 وتوفّي في العام 1689، زار إيران ست مرات بين العامَين 1632و1668م. وكانت أولى زيارة له في عهد الشاه صفي حفيد الشاه عبّاس الصفويّ، كما زار إيران في عهد الشاه عبّاس الثاني والشاه سليمان الصفويّ. وكتب كتابا عن رحلته (دانش بجوه، منوجهر، بررسى سفرنامه هاى دوره صفوى [دراسة مدوّنات الرحلات في العصر الصفويّ]، مصدر سابق: ص153ـ179).
كتاب تافرنيه يحتوي علي معلومات مفيدة ككتاب شاردن ويتطرق فيه إلى طرق إيران واوضاعها وتاريخ ومعتقدات وطقوس وآداب الإيرانيّين ولكن هذا الكتاب يحتوي على أخطاء ولا يمكن الاعتماد على هذا الكتاب لانه لم يكن يتقن الفارسية (زرين كوب، عبد الحسين، تاريخ إيران بعد از إسلام [تاريخ إيران بعد الإسلام]، مصدر سابق: ص107).
[255] بيضائي، بهرام، نمايش در إيران [العرض المسرحيّ في إيران]، مصدر سابق: ص116.
[256] سفرنامه تاورنيه [رحلة تافرنيه]، ترجمه بالفارسيّة أبو تراب نوري، تصحيح حميد شيراني، منشورات مكتبة سنائي، 1369هـ.ش [1990م]: ص412ـ414.
[257] المصدر السابق.
[258] آغا عبّاسي، يد الله، دانشنامه نمايش إيرانى [دائرة معارف العرض المسرحيّ في إيران]، منشورات: قطره، طهران، ط1، 1389هـ.ش [2010م]: ص66.
[259] زرين كوب، عبد الحسين، تاريخ إيران بعد از إسلام [تاريخ إيران بعد الإسلام]، مصدر سابق: ص106.
[260] جان شاردان السائح والفيلسوف الفرنسيّ بدأ رحلته إلى الشرق سنة 1665 عندما كان في الثانية والعشرين من عمره، وزار إيران ثلاث مرات وأقام في كلّ مرة ست سنوات، وبسبب إقامته المطوّلة في إيران تعلّم الفارسيّة وقرأ عن تاريخ إيران والإيرانيّين، وتقرب إلى الحاكم الصفويّ وكان يتعاطى بيع المجوهرات ولقّب بتاجر السلطان. سافر من إيران إلى الهند وبعد عودته إلى أوروبا لم يقم في فرنسا لأنّه كان بروتستانيّاً وكان الفرنسيّون يعاملون البروتستان معاملةً سيّئة وأقام في بريطانيا حتى وفاته. ويعدّ كتاب (رحلة شاردن إلى إيران والهند الشرقية) من أهم كتب الرحلات حيث تحدّث فيه عن إيران وعادات وتقاليد شعبها وتاريخ إيران ودين شعبها ومعيشة الإيرانيّين في عصره. نشر كتابه في باريس ويعدّ من أهم وأدق الكتب عن تاريخ العصر الصفويّ. ولد شاردان سنة 1643 في باريس وتوفّي في لندن في العام 1713(زرين كوب، عبد الحسين، تاريخ إيران بعد از إسلام [تاريخ إيران بعد الإسلام]، المصدر السابق: ص107).
[261] أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتی [مجموعة مقالات الندوة الدوليّة الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]، منشورات جمعيّة العروض المسرحيّة، طهران، ط1، 1390هـ.ش [2011م]: ص80.
[262] المصدر السابق: ص80.
[263] ولد جیمز موریه (James Justinian Morier) سنة 1780 في أزمير التركيّة، درس في بريطانيا وعاد إلى أزمير، وتعلّم اللغتين التركيّة والفارسيّة، زار إيران في القرن التاسع عشر تزامناً مع حكومة فتحعلیشاه القاجاريّ. عمل سكرتيراً لسفير بريطانيا في طهران هارفورد جونز. وبعد عام رافق سفير إيران المعيّن في بريطانيا الميرزا أبا الحسن خان الشيرازيّ إلى لندن، وكتب فيما بعد كتاباً عن السفير الإيرانيّ في بريطانيا. وفي سنة 1810 عاد إلى إيران وبقي فيها إلى سنة 1816م، وعمل مدّةً سفيراً لبريطانيا في طهران.
[264] موريه، جيمز، سه سال در دربار إيران، خاطرات دكتر موريه پزشك ويژه ناصر الدین شاه [ثلاث سنوات في البلاط الإيراني] (مذكرات الدكتور موريه الطبيب الخاص لناصر الدين شاه القاجاري)، ترجمه بالفارسية عبّاس إقبال الأشتيانيّ، بجهود همايون شهيدي، منشورات: دنيا الكتاب: ط2، ص270ـ 271.
[265] المصدر السابق.
[266] المصدر السابق.
[267] موريه، جيمز، سه سال در دربار إيران، خاطرات دكتر موريه پزشك ويژه ناصر الدین شاه [ثلاث سنوات في البلاط الإيراني].
[268] المصدر السابق.
[269] Eckhard Neubauer, “Muharram-Brauche in heutigen Persien.” Der Islam,1972, Bd. 49, Heft 2,249ـ272 ff.
[270] دايرة المعارف بناهاى تاريخى إيران در دوره إسلامى [دائرة معارف الأبنية التاريخيّة في إيران في العصر الإسلاميّ]، كاظم ملازاده، مريم محمدي، منشورات حوزه الفنون في مؤسّسة التبليغات الإسلاميّة، ط1، 1381ه.ش [2002م]: ص15؛ دهخدا، لغت نامه دهخدا، [معجم دهخدا]، (14 مجلّداً) منشورات جامعة طهران، ط1، 1373هـ.ش [1994م]: ج6، ص7970.
[271] محدثي، جواد، موسوعة عاشوراء، دار نشر معروف، قم، ط11، 1386هـ.ش [2007م]: ص142ـ143.
[272] راجع موقع ويكي فقه.
[273] دايرة المعارف بناهاى تاريخى إيران در دوره إسلامى [دائرة معارف الابنية التاريخية في إيران في العصر الإسلاميّ]، مصدر سابق: ص15.
[274] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسي مصايب در نمايش آيينى [قراءة التعزية، الحديث القدسي للمصائب في العروض المسرحية]، مصدر سابق: ص37؛ اللوحة منشورة في كتاب بعنوان (حسينيه مشير) [حسینیة مشیر]، من تأليف: صادق همايوني، منشورات سروش طهران: ط2، 1371هـ/ 1992م.
[275] بازار إيرانى [السوق الإيرانيّة]، إصدار: دائرة العمران وتخطيط المدن التابعة لوزارة الإسكان والتنظيم المدني، منشورات الجهاد الجامعيّة ـ طهران، ط 1، 1388هـ.ش [2009م]: ص17.
[276] المصدر السابق: ص17.
[277] بازار إيرانى [السوق الإيرانيّة]، إصدار: دائرة العمران وتخطيط المدن التابعة لوزارة الإسكان والتنظيم المدني، منشورات الجهاد الجامعيّة ـ طهران، ط 1، 1388هـ.ش [2009م]: ص18.
[278] الحج: آية32.
[279] «هرچه داریم از عزای امام حسین در محرم وصفر داریم. این محرم وصفر است که إسلام را زنده نگه داشته است»[كلّ ما لدينا هو من عزاء الإمام الحسين في محرم وصفر. إنّ محرم وصفر هما اللذان أبقيا الإسلام حيّاً]، صحیفه نور: ج15، ص204.
[280] الصحيح من سيرة الإمام الحسين بن علي×، إشراف العلامة السيد مرتضى العسكري ـ المحقق السيد محمّد باقر شريف القرشي والمؤرخ السيد هاشم البحراني، منشورات مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1430هـ/2009م: ص109.
[281] ري شهري، محمّد محمدي، فرهنگ نامه مرثیه سرایی وعزاداری سید الشهدا× [موسوعة قراءة المراثي والتعزية على سيّد الشهداء×]، منشورات دار الحدیث، قم 1387هـ.ش [2008م]: ص224.
[282] المصدر السابق: ص222.
[283] مطهري، مرتضى، حماسه حسينى [الملحمة الحسينيّة]، منشورات صدرا، ط 51، 1385هـ.ش [2006م]: ص37.
[284] ري شهري، محمّد محمّدي: فرهنگ نامه مرثيه سرايى وعزادارى سيد الشهداء× [موسوعة الرثاء وتعزية سيّد الشهداء×]، مصدر سابق: ص222.
[285] فتوى آية الله علي الخامنئيّ حول حرمة التطبير، منشور في موقعه على شبكة الانترنت: www.leader.ir
[286] آغا عبّاسى، يد الله، دانشنامه نمايش إيرانى [دائرة معارف العرض المسرحيّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ص108؛ بلوكباشي، علي، نخل گردانی [النخل الدوّار]، مكتب البحوث الثقافيّة: طهران، ط1، 1380هـ.ش [2001م]: ص 41ـ47.
[287] بلوكباشي، علي، نخل گردانی [النخل الدوّار]، مصدر سابق: ص41ـ47.
[288] المصدر السابق: ص36ـ37.
[289]المصدر السابق: ص38.
[290] نصري أشرفي، جهانغير، نمايش وموسيقى در إيران [العروض المسرحیّة والموسيقى في إيران]، منشورات ارون، طهران، ط1، 1383هـ.ش [2004م]: ص113.
[291] المصدر السابق: ص113.
[292] مشاهدات الباحث في كربلاء في الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
[293] المصدر السابق.
[294] أُطلقت كلمة (سقّاخانه) [مقرّ السقاية] أو (سبيلخانه) أو (سبيل ماء) على غرف صغيرة مخصّصة لتسبيل الماء في إيران، وكانت هذه الغرف الصغيرة المبنيّة من الأحجار توضع فيها المياه ليشرب منها المارّة. كما كانت توضع إلى جانبها أوانٍ فخاريّة أو أكواب زجاجيّة أو معدنيّة ليشرب منها المارة الماء البارد. بنيت السقاخانات في البداية لتقدّم الخدمات للمارّة وكان هدف مؤسّسيها الحصول على الثواب. بعض السقاخانات بنيت لتقدّم الماء للمارّة بصورة دائمة وبعضها أقيمت بصورة مؤقّتة في الأيام العشرة الأولى من شهر محرم وحتى العشرين من شهر صفر ذكرى أربعينيّة الإمام الحسين. ففي العصور الماضية التي لم تكن الكهرباء وسيلة للإضاءة في المدن كانت السقاخانات تضاء بالشموع حتى يراها المارّة. ولكن بمرور الوقت كان المارّة يوقدون الشموع في السقاخانات ولا سيّما ليالي الجمعة ويقدّمون النذور والمساعدات الماليّة ويلقونها في صناديق موضوعة إلى جانب السقاخانات. وفي العاصمة الإيرانيّة طهران والمدن الإيرانيّة بنيت سقاخات كبيرة في الطرق العامّة والأسواق والأزقة وكانت تزين بالصور وخاصّة صورة العبّاس بن علي أخ الحسين بن علي وعلي الأكبر ابن الإمام الحسين بن علي. وقد أُطلق على العبّاس بن علي اسم (سقاء كربلاء) واستشهد في كربلاء عندما ذهب لياتي بالماء إلى أطفال الحسين. ومن أبرز السقاخانات في إيران: سقاخانة الشيخ صفي الدين الأردبيلي في مدينة أردبيل التي شيّدت في القرن السادس عشر للميلاد وسقاخانة كوجه باغ في مدينة يزد والتي شيّدت في سنة 1517 م وسقاخانة عزيز الله في مدينة إصفهان وشيّدت في عصر سليمان الصفويّ (1666ـ1694م) وسقاخانة إسماعيل طلايي التي بناها نادر شاه أفشار في مشهد (1736ـ1747م). وشيّدت 290 سقاخانة في طهران من أبرزها سقاخانة خدابنده لو التي شيّدت في العصر القاجاريّ إلى جانب مقبرة سيّد إسحاق في وسط طهران، وسقاخانة نورزخان، وسقاخانة الشيخ هادي نجم آبادي، وسقاخانة آئینه. وكثير من هذه السقاخانات اندثرت بسبب الإهمال. وفي العصور الماضية كانت تخصّص أموال لشراء الثلج لتبريد الماء واستعيض عن الثلج بأجهزة تبريد توضع في السقاخات. ولا تزال في العاصمة طهران والمدن الإيرانيّة سقاخانات شيّدت في الأزمنة الغابرة، ولكنّها تزود المارّة بالماء (دهخدا، لغت نامه دهخدا، [معجم دهخدا بالفارسيّة]، مصدر سابق: ج 8، ص12058).
[295] هذه الأبيات منسوبة إلى سكينة بنت الإمام الحسين تقولها على لسان أبيها. راجع: محدثي، جواد، موسوعة عاشوراء، مصدر سابق: ج1، ص250.
[296] الصدوق، الأمالي، مصدر سابق: ص122.
[297] بيترسون، صموئيل، تعزيه وهنرهاى مربوط به آن [التعزیه والفنون المرتبطه بها]، مقال ضمن كتاب تعزيه آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص114.
[298] المصدر السابق: ص115.
[299] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسية في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص32.
(2) تنقل كتب الشيعة المؤلّفة خلال القرنين الماضيين قصّة السلطان قيس ملك الهند عندما هاجمه أسد وهو في الصيد، فتضرّع للإمام الحسين وطلب منه أن ينقذه من الأسد وقد أنقذه الإمام حسين. ولا تذكر هذه الكتب المصدر الذي نقلت عنه ويشكّك علماء الدين الشيعة في هذه القصّة ويرون أنّها غير موثوقة ولم يذكر ناقلوها المصدر الذي نقلوا القصّه منه (بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسية في التمثيل الديني]، مصدر سابق: ص32).
[301]بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسية في التمثيل الديني]، مصدر سابق: ص32.
[302] بيترسون، صموئيل، تعزيه وهنرهاى مربوط به آن [التعزية والفنون المتعلّقة بها]، مقال ضمن كتاب تعزيه، آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص116.
[303] المصدر السابق: ص117.
[304] المصدر السابق: ص116.
[305]بيترسون، صموئيل، تعزيه وهنرهاى مربوط به آن [التعزية والفنون المتعلّقة بها]: ص196.
[306] تاريخ هنر إيران [تاريخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج2، ص1462.
[307] تاريخ هنر إيران [تاريخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق؛ راجع مقال: رضا
عبّاسي رسّام الجداريّات الضخمة، في موقع إلاذاعة الإيرانيّة باللغة العربيّة:
http: //arabic.Irib.ir.reporter/item. iran-Arabic Radio.
[308] باکباز، رویین، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز [الرسم الإيرانيّ من ماضي الأیّام الی الیوم]، منشورات زرين وسيمين، طهران، ط10، 1390، هـ.ش [2011 م]: ص210.
[309] تاريخ هنر إيران [تاريخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج2، ص1464 ـ1467.
[310] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص30.
[[311]) المصدر السابق: ص30.
[312] المصدر السابق: ص30ـ31.
[313] المصدر السابق: ص31.
[314] باکباز، رویین، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز [الرسم الإيرانيّ من الماضي السحيق إلی الیوم]، مصدر سابق: ص201.
[315] هو أبو العبّاس القصاب مدفون بالقرب من مدينة الري جنوب طهران ومقبرته تعدّ من المزارات، تسمّى المحلّة التي فيها قبره محلّة (جوانمرد قصاب). تنقل روايات متعدّدة عنه في الفتوة والكرم والشجاعة، ويقال أنّه كان من أصحاب وأنصار الإمام علي بن أبي طالب.
[316] باکباز، رویین، نقاشی ایران از دیرباز تا امروز [الرسم الإيرانيّ من الماضي السحيق إلی الیوم]، المصدر السابق: ص201.
[317] حسن إسماعيل زاده، نقاش مكتب قهوه خانه اى [رسّام مدرسة المقاهي]، منشورات المؤسّسة الثقافيّة البحثيّة، منشورات: نظر، طهران، 1384هـ.ش [2005م]: ص10.
[318] فصلنامه هنر [فصليّة الفنّ]، مجموعة من المؤلّفين، بإشراف السيّد كمال حاج سيد جوادي، بجهود: أمير لواساني، منشورات الشركة المساهمة لمطبعة وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميّ، طهران، 1364هـ.ش [1985م]، العدد: 4، ص201.
[319] إسماعيل زاده، حسن، نقاش مكتب قهوه خانه اى [رسّام مدرسة رسوم المقاهي]، مصدر سابق: ص10.
[320] المصدر السابق.
[321] المصدر السابق: ص19.
[322] المصدر السابق.
[323] المصدر السابق: ص19ـ20.
[324] تاريخ هنر إيران [تاريخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج2، ص1464ـ1470.
[325] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص31.
[326] المصدر السابق: ص31.
[327] تاريخ هنر إيران [تاريخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج2، ص1113.
[328] محمّد غفاري المعروف بكمال الملك الرسّام الإيرانيّ، ولد سنة 1224 في مدينة كاشان وتوفّي في 1319هـ/ 1845ـ1940م في مدينة نيسابور وهو من أشهر الرسّامين الإيرانيّين في العصر القاجاريّ. نشأ في عائلة معروفة بحبّ الفنّ والرسم. بعد تلقّيه الدروس الابتدائيّة في مسقط رأسه، انتقل مع شقيقه إلى طهران وواصل دراسته في ثانويّة دار الفنون في فرع الرسم وعندما زار الحاكم القاجاريّ ناصر الدين شاه ثانويّة دار الفنون أعجب برسوم كمال الملك وأمر بأن يكون رسّام البلاط. توجّه كمال الملك سنة 1897 إلى إيطاليا وفرنسا لتعلّم الرسم الأوروبيّ وبعد ثلاث سنوات عاد إلى طهران وعمل في بلاط الحاكم القاجاريّ مظفّر الدين شاه ولم يتمكّن من مواصلة العمل في البلاط، فقد توجّه إلى العراق وأقام هناك عدّة سنوات، ولكنّه عاد إلى إيران أثناء الثورة الدستوريّة سنة 1906 واستمرّ في الرسم حتى وفاته سنة 1940.
[329] تشلكوفسكي، بيتر، تعزيه، آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص352.
[330] المصدر السابق.
[331] المصدر السابق.
[332] تشلكوفسكي، بيتر، تعزيه، آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق.
[333] مقال عاشورا در فيلم هاى ما [عاشوراء في أفلامنا]، بقلم زهره شريعتي منشور في مجلّة ديدار آشنا، بتاريخ اسفند 1383وفروردين 1384 [آذارـ مارس 2005 ونيسان ـ أبريل 2005]، العددان 55 و56.
[334] مقال (عاشورا در فيلم هاي ما) [عاشوراء في أفلامنا] بقلم زهره شريعتي منشور في مجلّة ديدار اشنا، بتاريخ اسفند 1383 وفروردين 1384 [اذار ـ مارس 2005 ونيسان ـ أبريل 2005] العددان 55 و56.
[335] صحیفة همشهري الإيرانيّة، بتاريخ 13 أيار ـ مايو 2015.
[336] معلومات استقيتها من الدكتورة دلال عبّاس التي تسكن مدينة النبطيّة.
[337] الحج: آية32.
[338] مقال لعبد الوهاب الكاشي، في كتاب (حلقة دراسية حول عاشوراء)، مصدر سابق: ص15، فضلاً عن المشاهدات الشخصيّة للباحث.
[339] مقال لعبد الوهاب الكاشي، في كتاب (حلقة دراسية حول عاشوراء)، مصدر سابق: ص16، والمشاهدات الشخصيّة للباحث.
[340]أ، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتى [مجموعة مقالات الندوة الدوليّة الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]، مصدر سابق: ص117ـ171.
[341] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف على قتلى الطفوف، مصدر سابق: ص178ـ180.
[342] شريف القرشيّ، باقر، حياة الإمام الحسين بن علي×، دراسة وتحليل، تحقيق مهدي باقر القرشيّ، الناشر قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة في العتبة الحسينيّة المقدّسة (3 أجزاء)، الطبعة 2، 1429هـ/ 2008م: ج3، ص308.
[343] آغا عبّاسي، يد الله، دانشنامه نمايش إيران [دائرة معارف العرض المسرحيّ في إيران]، مصدر سابق: ص98.
[344] أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاي آیینی وسنتى [مجموعة مقالات الندوة الدولية الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]، مصدر سابق: ص83.
[345] راجع موقع
مركز الأبحاث العقائديّة للحصول على معلومات أوفى عن فاطمة بنت الحسين:
http: //www.aqaed.com/faq/2906.
[346] المجلسيّ، محمّد باقر، بحار الأنوار، مصدر سابق: ج 45، ص60.
[347] شريف القرشي، باقر، حياة الإمام الحسين بن علي، مصدر سابق: ج 3، ص298.
[348] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار، مصدر سابق: ج45، باب 44، الحديث 16، ص60.
[349] الكاشانيّ، ملا حبيب الله شريف، تذكرة الشهداء (مقتل الإمام الحسین)، ترجمة: سید علی جمال أشرف، منشورات مدین، 1385هـ.ش [2006م]: ج 1، ص353.
[350] أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتى [مجموعة مقالات الندوة الدوليّة الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]: مصدر سابق، ص83.
[351] أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتى [مجموعة مقالات الندوة الدوليّة الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]، مصدر سابق: ص86.
[352] أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتى [مجموعة مقالات الندوة الدوليّة الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]، مصدر سابق: ص85.
[353] أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتى [مجموعة مقالات الندوة الدوليّة الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]، مصدر سابق: ص84، 85.
[354] بُني مرقد طفلَي مسلم بن عقيل في القرن الرابع الهجري في عهد عضد الدولة البويهيّ. وتم تحديث البناء بعد فتح بغداد على يد الشاه إسماعيل الصفويّ. قام الحاج ملا محمّد صالح برغاني القزوينيّ بتحديث البناء بين سنة 1243 و1246هـ، وللمرقد قبّتان وكلّ قبة تقع على قبر كلّ من محمّد وإبراهيم. البناء واسع يتسع للعديد من الزوار وبُنيت غرف حول المرقد ليقيم فيها الزوّار. وبني ضريحان من الذهب والفضة على المرقدين وقام بصنعهما فنانون إيرانيّون ودُشّن الضريحان سنة 2008م (انظر: http: //lazarboni.blogfa.com. تاريخ تصفّح الموقع 24ـ3ـ2015 الساعة 18 مساء).
[355] آغا عبّاسي، يد الله، دانشنامه نمايش إيرانى [دائرة معارف العرض المسرحيّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ص107.
[356] الصحيح من سيرة الإمام الحسين×، مصدر سابق: ص95.
[357] أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتى [مجموعة مقالات الندوة الدولية الثانية للعروض الدينيّة والتقليديّة]، مصدر سابق: ص94.
[358] وكالة أنباء مهر، 18ـ8ـ1392 الموافق ل 9 ت1ـ نوفمبر 2013م.
[359] الصحيح من سيرة الإمام الحسين بن علي×، مصدر سابق: ص105.
[360] صحيفة جام جم أونلاين (الإيرانيّة)، بتاريخ: 13 ابان 1392 الموافق ل 4 ت1 ـ أكتوبر 2013م.
[361] تاريخ هنر إيران [تاريخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج2، ص1117ـ1123.
[362] آرین بور، یحیی، از صبا تا نيما [من [الشاعر] صبا إلى [الشاعر] نیما]، منشورات زوار، طهران، ط6، 1375هـ.ش [1996م]: ج1، ص322.
[363] المصدر السابق: ج1، ص322.
[364] المصدر السابق: ص323.
[365] ينقل كاتب إيرانيّ وهو إبراهيم بوذري في كتابه (تعزيه در إيران و دو مجلس آن) [التعزیه في إیران ومجلسا تعزیة]: «أنّ یزيد بن معاوية قال بعد مقتل الحسين لمن صنعوا واقعة كربلاء أريد أن أشاهد الواقعة» فقاموا بتمثيل تلك الواقعة أمامه. لم نجد في كتب التاريخ هذا الكلام ولا ندري من أين أتى به الكاتب.
[366] تشلكوفسكي، بيتر، تعزيه، آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص170.
[367] فلسفي، نصر الله، زندگانى شاه عبّاس اول [حیاة الشاه عبّاس الأوّل]، مصدر سابق: ص233.
[368] بيضائي، بهرام، نمايش در إيران [العرض المسرحيّ في إيران]، مصدر سابق: ص118.
[369] نادرقلي الملقّب بطهماسب خان ونادر شاه أفشار من قبيلة أفشار من خراسان، حكم إيران من 1114إلى 1126هـ.ش [1735ـ1347م] وكان مؤسّس السلالة الأفشاريّة. وهو من أشهر ملوك إيران بعد الإسلام ويعده كثير من المؤرّخين من أقوى الملوك الإيرانيّين بعد الإسلام، فقد قمع الأفغان الذين احتلّوا إيران بعد سقوط الحكومة الصفويّة وطرد العثمانيّين والروس من إيران، وعزز الاستقلال وفتح الهند وتركستان وكانت حروبه السبب في انتشار سمعته، وفي أوروبا سمّي«آخر فاتحي الشرق ونابليون إيران والإسكندر الثاني» (شفق، رضا زاده، نادر شاه، منشورات ثالث، طهران، ط1، 1392هـ.ش [2013م]: ص221).
[370] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آيينى [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص23.
[371] راجع: http: //www.parvismamnun.at.
[372] مقال (التكية والتوحيد خانه والخانقاه في إيران)، بقلم د: محمّد نور الدين عبد المنعم، مجلّة شيراز الصادرة في طهران العدد 12.
[373] فرهنگ معين [معجم معين]، منشورات معين، ط7، 1384هـ.ش [2005م]، مادّة (تكيه).
[374] الخانقاه بالفارسيّة تعني الزاوية بالعربيّة أي المكان الذي يتجمّع فيه دراويش الصوفيّة.
[375] كياني، محسن، تاريخ خانقاه در إيران [تاريخ الخانقاه في إيران]، منشورات طهوري، طهران، ط1، 1369هـ.ش [1990م]: ص23.
[376] المصدر السابق: ص106.
[377] دايرة المعارف فارسى [دائرة المعارف الفارسيّة]، غلام حسين مصاحب، (مجلّدان)، منشورات أمير كبير، ط4، 1383هـ.ش [2004م]: ج1، ط2، ص661.
[378] محجوب، محمّد جعفر، مقال: تأثير تآتر اروپایی ونفوذ روشهای نمایشی آن در تعزیه [تأثير المسرح الأوروبيّ وتوغّل اساليببه التمثيليّة في التعزية]، في کتاب (تعزیه، آیین ونمایش در ایران) [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، لمؤلّفه تشلكوفسكي، مصدر سابق: ص202.
[379] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسي مصايب در نمايش آيينى [قراءة التعزیة حدیث المصائب القدسیة فی التمثيل الدینيّ]، مصدر سابق: ص94.
[380] تقيان، لاله، درباره تعزيه وتئاتر در إيران [حول التعزیه والمسرح في إیران]، منشورات مركز، طهران، ط1، 1374هـ.ش [1995م]: ص24.
[381] تقيان، لاله، درباره تعزيه وتئاتر در إيران [حول التعزیه والمسرح في إیران]، منشورات مركز، طهران، ط1، 1374هـ.ش [1995م]: ص24.
[382] ملك بور، جمشید، ادبیات نمایشی در ایران [الأدب المسرحيّ في إیران]، مصدر سابق: ج1، ص237.
[383] مقال (تعزيه وهنرهاى آن) [التعزیة وفنونها]، في كتاب تعزيه، آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، تأليف بيتر تشلكوفسكي، مصدر سابق: ص103.
[384] المصدر السابق.
[385] ملك بور، جمشید، ادبیات نمایشی در ایران [الأدب المسرحيّ في ایران]، مصدر سابق: ج1، ص237.
[386]مقال (تعزيه وهنرهاى آن) [التعزیة وفنونها]، في كتاب تعزية، آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص106.
[387] تشلكوفسكي، بيتر، آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص339.
[388] المصدر السابق.
[389] تشلكوفسكي، بيتر، آيين ونمايش در إيران [التعزية، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص340.
[390] المصدر السابق.
[391] بنجامين، س. ج، سفرنامه إيران وإيرانيان [الرحلة إلى إیران، والإيرانيّون]، ترجمه بالفارسيّة: محمّد حسين كردبجه، منشورات جاويدان، طهران، لا تا: ص282.
[392] ولد آلکساندر ادمون خودزکو في كشويسه في لتوانيا سنة 1804م، درس المراحل الأولى في جامعة ويلنا والأكاديمية الشرقيّة في سان بطرسبورغ. تعلّم اللغات الشرقيّة في روسيا وكذلك تعلّم الفرنسيّة والانجليزيّة. عمل في حكومة القيصر وبسبب معرفته باللغات الشرقيّة عيّن مترجماً في السفارة الروسيّة في طهران، وتوجّه إلى مدينة رشت (شمالي إيران) بعد أن عُيّن نائباً للقنصل الروسي ّفيها. تعلّم الفارسية جيّداً وعُرف في إيران باسم (ميرزا الكسندر). قام خلال إقامته في إيران والتي استمرّت إحدى عشرة سنة بدراسة اللهجات المحليّة الإيرانيّة حول بحر قزوين، وجمع نماذج من الأشعار والأغاني المحليّة، والكلمات والمصطلحات المتداولة في هذه المنطقة. وكتب مقالات عن الثقافة والفنّ والتاريخ الإيرانيّ، وفي العام 1840م استقال من منصبه وغادر إيران، وبعد سنة تلقّى عرضاً من مدرسة اللغات الشرقيّة في باريس، لتدريس اللغة الفارسيّة، وذهب إلى باريس وتولّى مسؤوليّة القسم الفارسيّ في هذه المدرسة. وتولّى في العام 1858 مسؤوليّة كرسي اللغات والأدب في كولدج دو فرانس. توفّي في العام 1892م في نوازي لوسك بالقرب من باريس (رستمي، محمّد، إيران شناسان وادبيات فارسى [علماء الإيرانيّات والأدب الفارسيّ]، منشورات مركز أبحاث العلوم الإنسانيّة والدراسات الثقافيّة، طهران، ط1، 1390هـ.ش [2011م]: ص399).
[393] ستاري، جلال، پرده هاى بازى [ستائر العرض المسرحيّ]، منشورات ميترا، طهران، ط1، 1379هـ.ش [2000م]: ص37ـ38؛ عاشور بور، صادق، نمايش هاى إيرانى [العروض المسرحیّة الإيرانيّة]، منشورات سوره مهر، ط 1، 1381هـ.ش [2002م]: ص523ـ 524.
[394] يشير الكونت دو كوبينو إلى مقتل جعفر بن يحيى البرمكي وجميع أفراد العائلة البرمكيّة بأمر من هارون الرشيد في العام 187هـ بعد غضبه عليهم بسبب تعاظم دورهم وشعوره بخطرهم على حكمه.
[395] سه سال در آسیا، سفرنامه كنت دو گوبینو، 1855ـ1858 [رحلة الكونت دو كوبينو ـ ثلاث سنوات في آسيا]، مصدر سابق: ص430.
[396] المصدر السابق.
[397] جورج. ن.كورزن، إيران وقضية إيران [إيران والقضيّة الإيرانیّة]، ترجمه بالفارسيّة غلام علي وحيد المازندرانيّ: ج1، ص430ـ432.
[398] المصدر السابق: ص 433ـ434.
[399] المصدر السابق.
[400] جورج. ن.كورزن، إيران وقضية إيران [إيران والقضيّة الإيرانیّة]، ترجمه بالفارسيّة غلام علي وحيد المازندرانيّ: ص430ـ432.
[401] تعزیه: آیین ونمایش در ایران [التعزیة، العروض التقليديّة في إيران]: ص242؛ مقال (کتابشناسی) بقلم: بيتر تشلكوفسكي في کتاب (تعزیه: آیین ونمایش در ایران) [التعزیة، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص335.
[402] مقال: تعزيه وهنرهاى آن [التعزیه وفنونها] بقلم صاموئيل بیترسون في کتاب (تعزیه: آیین ونمایش در ایران) [التعزیة، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص114ـ115.
[403] السائحة وعالمة الآثار الفرنسيّة مدام جان ديولافوا (1843ـ1920) زارت إيران مع زوجها مارسل أوكست ديولافوا المهندس وعالم الآثار الفرنسيّ (1843ـ1920) مبعوثَين من قبل الحكومة الفرنسيّة للقيام بحفريات في المواقع الاثريّة في إيران. كانت زيارتهما الأولى في العام 1881 وزارا جنوبيّ إيران. وكانت مدام ديولافوا تكتب مشاهداتها ونتائج حفريّات زوجها كلّ يوم ونشرتها في كتابين. الكتاب الأوّل طٌبع بعنوان (زيارة ديولافوا إلى إيران وشوش وكلده) وهو أحد المصادر في تاريخ العصر القاجاريّ ولا سيّما عصر ناصر الدين شاه والأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة للشعب الإيرانيّ في العصر المذكور ويتضمّن الكتاب صوراً ورسوماً أعدّتها الكاتبة. الكتاب الثاني يتضمّن مذكّراتها عن زيارتهما الثانية والثالثة لإيران بين العامَين 1884 و1886. نقل الفرنسيّان آثاراً تاريخيّة كثيرة من القصور الهخامنيّة وخاصّة عن داريوش الكبير وأردشير الثاني إلى متحف اللوفر الفرنسيّ (رحلة ديولافوا في العصر القاجاريّ، ترجمه بالفارسيّة بهرام فره وشي، منشورات مكتبة خيام: ط2، ص111).
[404] سفرنامه ديولافوا در عصر قاجار [رحلة ديولافوا في العصر القاجاريّ]، مصدر سابق: ص111.
[405]سفرنامه ديولافوا در عصر قاجار [رحلة ديولافوا في العصر القاجاريّ]، مصدر سابق: ص111.
[406] مقال (کتابشناسی) [بيبليوغرافيا] بقلم: بیتر جی. تشلکوفسکي في کتاب( تعزیه: آیین ونمایش در ایران) [التعزیة، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص242.
[407] تئاتر إيرانى [المسرح الإيرانيّ]، أنريكو جرولي، نقلاً عن (نمايش در شرق) [التمثیل في المشرق]، مجموعه مقالات، ترجمه بالفارسیّة جلال ستاري، ربیع 1367 هـ.ش [1988م]: ص31ـ32 و36ـ37.
[408] تشلكوفسكي، بیتر جي، تعزیه: آیین ونمایش در ایران [التعزیة، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص344.
[409] المصدر السابق.
[410] المصدر السابق.
[411] مقال بقلم برويز ممنون بعنوان: تعزيه از ديدگاه تئاتر غرب [التعزیه من وجهة نظر المسرح الأوروبيّ]، في كتاب تعزیه: آیین ونمایش در ایران [التعزیة، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص192ـ209.
[412] مقال بقلم برويز ممنون بعنوان: تعزيه از ديدگاه تئاتر غرب [التعزیه من وجهة نظر المسرح الأوروبيّ]، في كتاب تعزیه: آیین ونمایش در ایران [التعزیة، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق.
[413] مقال بقلم برويز ممنون بعنوان: تعزيه از ديدگاه تئاتر غرب [التعزیه من وجهة نظر المسرح الأوروبيّ]، في كتاب تعزیه: آیین ونمایش در ایران [التعزیة، العروض التقليديّة: ص192ـ209.
[414] آية الله الشيخ مرتضى مطهّري (1920ـ 1979) عالم دين وفيلسوف إسلاميّ شيعيّ، العضو المؤسّس في شورى الثورة الإسلاميّة في إيران إبّان الأيام الأخيرة من سقوط نظام الشاه، صاحب الشبكة الواسعة من المؤلّفات التأصيليّة والعقائديّة والفلسفيّة الإسلاميّة، وأحد أبرز تلامذة المفسر والفيلسوف الإسلاميّ آية الله السيّد محمّد حسين الطباطبائيّ.
[415] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار، مصدر سابق: ج 44، ص330.
[416] مطهّري، مرتضى، تحريفات در واقعه تاريخى كربلا [تحريفات في واقعة كربلاء التاريخية]، منشورات صدرا، ط1، 1391هـ.ش [2012م]: ص31ـ43.
[417] مطهّري، مرتضى، تحريفات در واقعه تاريخى كربلا [تحريفات في واقعة كربلاء التاريخية]: ص21ـ22.
[418] الشيخ عبّاس القميّ المعروف بالمحدّث القميّ من رجال الحديث عند الشيعة في القرن الرابع عشر للهجرة، ويعرف الشيخ عبّاس القميّ بكتابه (مفاتيح الجنان) ويضمّ مجموعة من الأدعية المنقولة عن الأئمّة الشيعة وقد جمعها الشيخ القميّ في كتابه (مفاتيح الجنان)، درس العلوم الحوزويّة في مدينة قم ومنها انتقل في العام 1316هـ إلى مدينة النجف الأشرف في العراق لمواصلة دراسته الدينيّة. ولد الشيخ عبّاس القمي في مدينة قم في العام 1294هـ /1875م، ودرس مقدّمات العلوم الدينيّة في مسقط رأسه، وفي الثانية والعشرين من عمره توجّه إلى النجف الأشرف لمتابعة دراسته الحوزويّة وبقي هناك ستّ سنوات عاد بعدها إلى إيران وبقي في قم حتى وفاته في العام 1359هـ. نُقل جثمانه إلى النجف الأشرف ودفن هناك. من مؤلّفات الشيخ عبّاس القمي الأخرى كتاب (منتهى الآمال).
[419] فاطمة بنت الحسين، زوجة الحسن بن الحسن الذي خرج مع عمّه الحسين إلى العراق ومعه زوجته فاطمة، واستشهد في كربلاء، وجيء بها مع السبايا إلى دمشق ولما أُدخلت نساء الحسين على يزيد والرأس بين يديه جعلت فاطمة وسكينة يتطاولان لينظرا إلى الرأس، وجعل يزيد يتطاول ليستر عنهما الرأس، فلمّا رأت النسوةُ الرأس صحن فصاحت نساء يزيد، وولولت بنات معاوية، فقالت فاطمة بنت الحسين×: أبنات رسول الله سبايا يا يزيد فبكى الناس وبكى أهل داره، حتى علت الأصوات. قال المفيد إنّ أمها أم إسحق بنت طلحة بن عبد الله تميميّة، وفي تذكرة الخواص أنّها توفيت في العام 117هـ. وقال المفيد في الإرشاد كانت فاطمة بنت الحسين× تقوم الليل وتصوم النهار، وكانت تشبّه بالحور العين لجمالها (محسن الأمين، أعيان الشيعة، مصدر سابق، مادة: فاطمة).
[420] القمّيّ، الشيخ عبّاس، منتهى الآمال، منشورات الهجرة، قم، ط 8، 1373هـ.ش [1994م]: ج1، ص700.
[421] العلّامة الحاج ميرزا حسين محدّث النوري المعروف باسم خاتم المحدّثين، ولد في العام 1254 في قرية يالرود التابعة لمدينة نور شماليّ إيران وتوفّي في العام 1320هـ في مدينة النجف الأشرف. له مؤلفات عدّة منها كتاب (لؤلؤ ومرجان) في وظائف الخطباء والوعاظ (مخطوط)؛ ودار السلام وشاخه طوبى؛ وديوان شعر مؤلّف من ألف بيت وكتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل.
[422] القمّيّ، الشيخ عبّاس، منتهى الآمال: ج1، مصدر سابق، ص700.
[423] بيشدار، رؤوف، تعزيه زمينه قزوين [التعزیة الخاصّة بقزوین]، رسالة ماجستیر غیر مطبوعة، 1388هـ.ش [2010م]، ص79.
[424] المصدر السابق.
[425] واعظ كاشفي، ملا حسين، روضة الشهداء، تصحيح: آية الله حاج شيخ أبو الحسن الشعرانيّ، منشورات المكتبة الإسلاميّة، لا تا: ص323ـ329.
[426] مطهّري، مرتضى، تحريفات در واقعه تاريخى كربلا [تحریفات فى واقعة کربلاء التاريخيّة]، مصدر سابق: ص44.
[427] عاشورانامه [موسوعة عاشوراء]، مصدر سابق: ص224.
[428] القصّة بكاملها مذكورة في كتاب (روضة الشهداء) لمؤلّفه الملا حسين واعظ كاشفي، مصدر سابق: ص346.
[429] الآخوند الملا آغا بن عابد بن رمضان علي بن عابد الشيروانيّ المعروف ب آغا بندري أو فاضل دربندي حائري (المتوفّى في العام 1286) واعظٌ درس في الحوزة العلميّة في النجف وكربلاء وأقام في طهران. من أهمّ كتبه: (إكسير العبادات في أسرار الشهادات) في ثلاث مجلّدات، حقّقه الشيخ محمّد جمعة بادي والأستاذ عبّاس ملا عطية الجمري، الطبعة الأولى في العام 1415هـ/ 1994م، منشورات شركة المصطفى للخدمات الثقافيّة، المنامة ـ البحرين. وهو كتاب يتحدّث عن مقتل الحسين وفيه روايات ضعيفة وغير موثّقة.
[430] عاشورانامه، مصدر سابق: ج 4، ص208.
[431] المصدر السابق.
[432] محجوب، جعفر، في مقالة بعنوان: (تأثير تئاتر اروبائى ونفوذ روش هاى نمايشى آن در تعزيه) [تاثیر المسرح الأوروبيّ ونفوذ أسالیبه المسرحیّة في التعزیة]، راجع كتاب تعزيه هنر بومى بيشرو إيران [عروض التعزیة، الفنّ المحليّ الطليعيّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ص170ـ 179.
[433] المصدر السابق.
[434] تعزيه هنر بومى بيشرو إيران [عروض التعزیة، الفنّ المحليّ الطليعيّ الإيرانيّ]، مصدر سابق.
[435] مارتن ورمارزن، آیین میترا [دیانة میترا]، ترجمه بالفارسيّة: نادر بزركزاد، منشورات الينبوع، طهران، ط9، 1393هـ.ش [2014م]: ص17.
[436] شريعتي، علي، تشيع علوى وتشيع صفويى [التشیّع العلويّ والتشیّع الصفويّ]، لا ط.، لا تا: ص206.
[437] المصدر السابق: ص206ـ207.
[438] أشرفي، جهانغير نصري، از آيين تا نمايش [من الدین إلی التمثيل]، منشورات ارون، ط1، 1391هـ.ش [2012م]: ج1، ص588.
[439] نيازمند، رضا، شيعه در تاريخ إيران [الشیعه في تاریخ إیران]، مصدر سابق: ص175ـ176.
[440] مقال بقلم برويز ممنون، بعنوان: تعزيه از ديدگاه تئاتر غرب [التعزیه من وجهة نظر المسرح الأوروبيّ] في كتاب (تعزیه: آیین ونمایش در ایران) [التعزیة، العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص192ـ209.
[441]مقال بقلم برويز ممنون، بعنوان: تعزيه از ديدگاه تئاتر غرب [التعزیه من وجهة نظر المسرح الغربيّ]: ص192ـ209.
[442] مقال بقلم برويز ممنون بعنوان: تعزيه از ديدگاه تئاتر غرب [التعزیه من وجهة نظر المسرح الأوروبيّ] في كتاب (تعزیه: آیین ونمایش در ایران) [التعزية: العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص206ـ207.
[443] حسيني، ناصر، تئاتر معاصر إيران [المسرح الإیرانيّ المعاصر]، مركز العروض الفنيّة الوطنيّة، طهران، ط1، 1377هـ.ش [1998م]: ج1، ص63ـ64.
[444] المصدر السابق.
[445] جميلي، عبّاس خدوم، تعزيه در عراق [التعزية في العراق] مصدر سابق: ص79ـ80.
[446] تاريخ هنر إيران [تاریخ الفن الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج2، ص 953.
[447] جميلي، عبّاس خدوم، تعزيه در عراق [التعزية في العراق] مصدر سابق: ص80.
[448] راجع ابن تيمية، تقي الدين، الفتاوى الكبرى، مصدر سابق: ج1، ص196.
[449] بیشدار، رؤوف، تعزیه زمینه قزوین [التعزية الخاصة بقزوين (مدينة إيرانيّة)]، مصدر سابق: ص44ـ45.
[450] عاشور بور، صادق، نمايش هاى إيرانى [العروض المسرحيّة الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص207.
[451] عاشور بور، صادق، نمايش هاى إيرانى [العروض المسرحيّة الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص214.
[452] تاريخ هنر إيران [تاريخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج1، ص548.
[453] تشلكوفسكي، بيتر، تعزيه، هنر بومى پيشرو إيران [التعزیة، الفنّ المحليّ الإيرانيّ الطلیعيّ]، مصدر سابق: ص21.
[454] بیشدار، رئوف، تعزیه زمینه قزوین [التعزية الخاصّة بقزوين]، مصدر سابق: ص48.
[455] تشلكوفسكي، بيتر، تعزيه نمايش بومي بيشرو إيران [عروض التعزیة، الفنّ المحليّ الإيرانيّ الطليعيّ]، مصدر سابق: ص21.
[456] عاشور بور، صادق، نمايش هاى إيرانى [العروض الإيرانيّه]، مصدر سابق: ص136.
[457] تشلكوفسكي، بيتر، تعزيه نمايش بومى بيشرو إيران [عروض التعزیة، الفنّ المحليّ الإيرانيّ الطليعيّ]، مصدر سابق: ص21.
[458] عاشور بور، صادق، نمايش هاى إيرانى [العروض المسرحيّة الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص 136.
[459] أردلان، حميد رضا، مجموعة مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتی [مجموعة مقالات الندوة الدولیّة الثانية للعروض الدینیّة والتقلیدیّة]، مصدر سابق: ص113.
[460] عاشور بور، صادق، نمايش هاي إيرانى [العروض المسرحيّة الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص478.
[461] المصدر السابق: ص485.
[462] المصدر السابق: ص488.
[463] عاشور بور، صادق، نمايش هاي إيرانى [العروض المسرحيّة الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص489.
[464] المصدر السابق: ص496.
[465] المصدر السابق: ص500.
[466] المصدر السابق: ص498.
[467] عاشور بور، صادق، نمايش هاي إيرانى [العروض المسرحيّة الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص502.
[468] هود: آية7.
[469] المصدر السابق: ص504.
[470] المصدر السابق: ص505.
[471] المصدر السابق: ص506.
[472]عاشور بور، صادق، نمايش هاي إيرانى [العروض المسرحيّة الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص507.
[473] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى: حديث قدسى مصايب در نمايش آيينى [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص166.
[474] بیشدار، رئوف، تعزیه زمینه قزوین [التعزية الخاصّة بقزوین]، مصدر سابق: ص49.
[475] من أشهر الموسيقيّين الإيرانيّين، ولد في العام 1902 في طهران، تعلّم الموسيقى من والده وأساتذة موسيقى عصره، درس في مدرسة الموسيقى في طهران وتعلّم الضرب على جميع الآلات الموسيقيّة الإيرانيّة. أسّس مدرسة للموسيقى في مدينة رشت في شماليّ إيران وعندما أسّست الإذاعة الإيرانيّة في العام 1939 التحق بها لیرأس قسم الموسيقی فيها. كما أقام دورات لتعليم الموسيقى في أواخر حياته. كان يهوى الرسم والشعر، وكانت له علاقة بشعراء عصره أبرزهم الشاعر محمّد حسين شهريار ورائد الشعر الحرّ في إيران نيما يوشيج. توفّي في العام 1957 إثر نوبة قلبيّة.
[476] صبا، أبو الحسن، (من مذكرات صبا)، مجلة الموسيقى، العدد 18، بهمن 1336 [يناير 1958]، طهران: ص10.
[477] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى: حديث قدسى مصايب در نمايش آيينى [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص157.
[478] بیشدار رئوف، تعزیه زمینه قزوین [التعزية الخاصّة بقزوين]، مصدر سابق: ص50.
[479] نصري أشرفي، جهانغير، نمایش وموسیقی در إيران [العرض المسرحيّ والموسيقى في إيران]، مصدر سابق: ص77.
[480] نصري أشرفي، جهانغير، نمایش وموسیقی در إيران [العرض المسرحيّ والموسيقى في إيران]، مصدر سابق.
[481] جهانغیري، نصري أشرفي وعبّاس شیرزادي آهودشتي، تاريخ هنر إيران [تاریخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج2، ص948.
[482] جهانغیري، نصري أشرفي وعبّاس شیرزادي آهودشتي، تاريخ هنر إيران [تاریخ الفنّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ج2، ص948.
[483] المصدر السابق: ج2، ص967.
[484] واعظ كاشفي، ملا حسين، المتوفّى في العام 910هـ، صاحب كتاب روضة الشهداء، مصدر سابق.
[485] جوهري المروزيّ، ميرزا محمّد إبراهيم (المتوفّى في العام 1252هـ)، طوفان البكاء، در مصائب ائمه اطهار بخصوص سيد الشهداء [طوفان البكاء في مصائب الأئمّة الأطهار لا سيّما سید الشهداء]، منشورات طوباي محبت، ط1، 1390هـ.ش [2011م]، ضمّ أشعاراً في رثاء الإمام الحسين.
[486] طريق البكاء لمؤلِّفه محمّد حسين أبي مرحمت بناه ملا عبد الله شهرابي لقبه الأدبيّ ( گريان) [البکّاء]، یضمّ هذا الکتاب 60 مجلساً للعزاء على الحسين بن علي، كتبه مؤلّفه بعدد أيام شهري محرم وصفر. يضمّ هذا الكتاب أشعاراً لشعراء إيرانيّين يصل عددهم إلى 35 شاعراً منهم: محتشم الكاشانيّ ووصال الشيرازيّ وصبا والجوهري وجودي ورضوان وسروش، وأحاديث الرواة وحكاياتهم ومنهم الشهيد الثالث وأبو مخنف ودربندي أو الكتبي (أردلان، حميد رضا، مجموعه مقالات دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آيينى وسنتى [المجموعة الثانیة للندوة الدولیّة للعروض الدینیّة والتقلیدیّة]، مصدر سابق: ص63).
[487] عاشوربور، صادق، نمايش هاى إيرانى [العروض المسرحية الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص338ـ339.
[488] عاشوربور، صادق، نمايش هاى إيرانى [العروض المسرحية الإيرانيّة]، مصدر سابق: ص340.
[489] آغا عبّاسي، دانشنامه نمايش إيرانى [دائرة معارف العرض المسرحيّ الإيرانيّ]، مصدر سابق: ص68.
[490] بیشدار، رؤوف، تعزیه زمینه قزوین [التعزية الخاصة بقزوين]، مصدر سابق: ص55.
[491] شهیدي، عنایت الله: مقال بعنوان: (دگرگونی وتحول در ادبیات وموسیقی تعزیه) [التغییر والتحول فی أدب وموسیقی التعزیة]، في کتاب: (تعزیه: آیین ونمایش در ایران) [التعزية: العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص67 نقلاً عن عبد الله المستوفي.
[492] بیشدار، رؤوف، تعزیه زمینه قزوین [التعزية الخاصة بقزوين]، مصدر سابق: ص43 و57.
[493] محمّد زاده، مرضية، عاشورا در شعر معاصر وفرهنگ عامه [عاشوراء في الشعر المعاصر وثقافة العامّة]، منشورات (مجمع عاشوراء الثقافيّ)، طهران، ط1، 1389هـ.ش [2010م]: ص420.
[494] المصدر السابق.
[495] المصدر السابق: ص421.
[496] المصدر السابق: ص420.
[497] محمّد زاده، مرضية، عاشورا در شعر معاصر وفرهنگ عامه [عاشوراء في الشعر المعاصر وثقافة العامّة].
[498] همايوني، صادق، تعزيه وتعزيه خوانى [التعزية وقراءة التعزية]، لا تا: ص45ـ63.
[499] مسعودية، محمّد تقي، موسيقى مذهبى إيران [الموسیقی الدینیّة في إیران]: ج1، ص30.
[500] قامت زهرا إقبال (نامدار) بجمع 33 نصّاً في كتاب بعنوان (جنگ شهادت) [دفتر الشهادة]، بإشراف الدكتور محمّد جعفر محجوب في مجلّدين وطُبع الكتاب في دار منشورات سروش في العام 1976.
[501] مسعودية، محمّد تقي، موسيقى مذهبى إيران [الموسيقى الدينيّة في إيران]: ج1، ص29ـ30.
[502] م.ن: ج1، ص29ـ30.
[503] مسعودية، محمّد تقي، موسيقى مذهبى إيران [الموسيقى الدينيّة في إيران]: ج1، ص30.
[504] م.ن: ج1، ص31.
[505] أردلان، حميد رضا، مجموعة دومين سمينار بين المللى نمايش هاى آیینی وسنتی [المجموعة الثانیة للندوة الدولیّة للعروض الدینیّة والتقلیدیّة]، مصدر سابق: ص17ـ65.
[506] هذه القصّة من قصص العامّة، وهي من وحي القصّة التي تقول إن قتل الإمام هو المهر الذي قدّمه ابن ملجم (قاتل عليّ) لعشيقته.
[507] نقلاً عن كتاب صادر عن (دومين همايش سراسري آیین های عاشورایی) [المؤتمر الثاني الموسّع للمراسم العاشورائیّة): ص76ـ95.
[508] حلقة دراسيّة حول عاشوراء، مصدر سابق: ص86.
[509] أمير كبير، هو المیرزا محمّد تقي خان فراهاني (1186ـ1230هـ/ 1805ـ1851م)، رئيس وزراء ناصر الدين شاه القاجاريّ.
[510] مقال: تأثير تئاتر اروپایی ونفوذ روشهای نمایشی آن در تعزیه [تاثير المسرح الأوروبيّ ونفوذ أساليبه التمثيليّة في التعزية]، بقلم محمّد جعفر محجوب، في كتاب تعزيه: آيين ونمايش در إيران [التعزية: العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص184ـ185؛ ملك بور، جمشيد، ادبيات نمايشى در إيران [الأدب المسرحيّ في إیران]، مصدر سابق: ج1، ص235).
[511] راجع: بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى حديث قدسى مصايب در نمايش آيينى [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص168.
[512] واعظ كاشفي، ملا حسين، روضة الشهداء، مصدر سابق: ص262ـ267.
[513] مسرح المدينة (المسمّى تياتر شهر) في طهران: هو أكبر مسرح لإقامة العروض المسرحيّة في إيران، بدأ بناء المسرح في العام 1967 بتصميم من المهندس الإيرانيّ علي سردار أفخمي واستمرّ بناؤه خمس سنوات. وقد افتتح المسرح في العام 1972 بعرض أوّل مسرحية بعنوان: باغ ألبالو [بستان الكرز] لمولّفه: انطوان تشيخوف وقام بإخراج المسرحيّة أربي أوانسيان (fa.wikipedia.org/wiki/).
[514] الخوارزميّ، أبو الموفق المؤيّد، مقتل الحسين، تحقيق: الشيخ محمّد السماويّ، دار أنوار الهدى، لا تا: ج1، ص338.
[515] الجوهريّ، الميرزا محمّد إبراهيم المروزي، طوفان البكاء، مصدر سابق: ص564ـ567.
[516] الخوارزميّ، أبو المؤيّد، مقتل الحسين، مصدر سابق: ج2، ص37. * الصحيح ( جعفرا ) لأنه بدل من ( ذا الجناحين ) .
[517] واعظ كاشفي، ملا حسين، روضة الشهداء، مصدر سابق: ص346.
[518] النساء: آية 78.
[519] آل عمران: آية154.
[520] راجع: مطهري، مرتضى، تحريفات عاشوراء، مصدر سابق: ص94.
[521] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار، مصدر سابق: ج44، ص330ـ331.
[522] الجوهري، الميرزا محمّد إبراهيم المروزي، طوفان البكاء، مصدر سابق: ص564ـ567.
[523] هذه القصّة وردت في مجالس التعزية التي تقرأ في إيران وهي من القصص التي لم ترد في كتب المقاتل والكتب التاريخيّة.
[[524]) الجوهري، الميرزا محمّد إبراهيم المروزي، طوفان البكاء، مصدر سابق: ص583ـ 598.
[525] حلقة دراسية حول عاشوراء، مصدر سابق: ص25.
[526] المصدر السابق: ص81.
[527] ولد في مدينة النجف الاشرف بالعراق في العام 1279هـ/1862م وترعرع في بلدة الخيام في جنوب لبنان، ثم درس العلوم الدينيّة في النجف وبعد تخرّجه من جامعة النجف طلب ليكون أمام النبطيّة في مطلع القرن العشرين (المصدر السابق: ص21ـ22).
[528]المصدر السابق: ص25.
[529] الخوارزميّ، أبو المؤيّد الموفّق، مقتل الحسين، مصدر سابق: ص321.
[530] حلقة دراسيّة حول عاشوراء، مصدر سابق: ص84.
[531] المصدر السابق: ص85.
[532] مقال فصول من تاريخ المسرح العراقيّ بقلم: لطيف حسن. موقع الناس على شبكة الانترنت:
http: //al-nnas.com.
[533] المصدر: تقرير ليلى بسام، من وكالة أنباء رويترز.
[534] تقرير ليلى بسام، من وكالة أنباء رويترز.
[535] تقرير ليلى بسام، من وكالة أنباء رويترز.
[536] مقال فصول من تاريخ المسرح العراقيّ بقلم: لطيف حسن. موقع الناس على شبكة
الانترنت:
http: //al-nnas.com.
[537] ولد عبد الرحمن الشرقاوي في 10 ت2/نوفمبر 1920م بقرية الدلاتون محافظة المنوفية شماليّ القاهرة، بدأ عبد الرحمن تعليمه في كتّاب القرية، ثمّ أنتقل إلى المدارس الحكوميّة حتى تخرّج من كليّة الحقوق في جامعة فؤاد الأوّل العام 1943م. بدأ حياته العمليّة بالمحاماة، ولكنّه هجرها لأنّه أراد أن يصبح كاتباً فعمل في الصحافة، في مجلّة الطليعة في البداية، ثمّ مجلة الفجر، وعمل بعد ثورة 23 يوليو 1952 في صحيفة الشعب، ثم صحيفة الجمهوريّة، ثمّ شغل منصب رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، عمل بعدها في جريدة الأهرام، كما تولّى عدداً من المناصب الأخرى منها سكرتير منظّمة التضامن الآسيويّ الأفريقيّ وأمانة المجلس الأعلى للفنون والآداب.
رواياته: الأرض في العام 1954، وقلوب خالية في العام 1956م، ثم الشوارع الخلفيّة العام 1958م، وأخيرا الفلاح في العام 1967م.
تأثّر عبد الرحمن الشرقاوي بالحياة الريفيّة، وكانت القرية المصريّة مصدرَ إلهامه، وانعكس ذلك على أوّل رواياته الأرض التي تعدّ أول تجسيد واقعيّ في الإبداع الأدبيّ العربيّ الحديث، وقد تحوّلت هذه الرواية إلى فيلم سينمائيّ شهير بالاسم نفسه من أخراج يوسف شاهين في العام 1970م.
من أشهر أعماله مسرحيّة الحسين ثائراً، ومسرحيّة الحسين شهيداً ومأساة جميلة، عن المناضلة الجزائريّة جميلة بوحيرد ومسرحيّة الفتى مهران، والنسر الأحمر، وأحمد عرابي، أمّا في مجال التراجم الإسلاميّة فقد كتب محمّد رسول الحريّة وعلي إمام المتقين، والفاروق عمر. كما شارك في سيناريو فيلم الرسالة بالاشتراك مع توفيق الحكيم، وعبد الحميد جودة السحّار. حصل عبد الرحمن الشرقاوي على جائزة الدولة التقديريّة في الآداب في العام 1974 والتي منحها له الرئيس السادات، كما منحه معها وسام الآداب والفنون من الطبقة الأولى. توفي في 10 ت2/نوفمبر 1987.
[538] مجلة روز اليوسف، 13ـ3ـ2010 نقلاً عن موقع مصرس.
[539] الأرسي: كلمة فارسيّة تعني الغرفة المزجّجة المطلّة على فناء الدار (فرهنگ فارسی معین [معجم معين]: ص122).
[540] موقع مصرس، نقلاً عن اليوم السابع بتاريخ 1ـ12ـ2010م http: //www.masress.com.
[541] موقع (العالم اليوم) بتاريخ 22 ـ2ـ 2012م: http: //www.gn4me.com/alalamalyoum/inner.
[542] موقع مصرس، نقلا عن صحيفة الفجر بتاريخ 24ـ3ـ2012 http: //www.masress.com.
[543] موقع مصرس، نقلا عن اليوم السابع بتاريخ 1ـ12ـ2010م: http: //www.masress.com.
[544] مقال بقلم: يحيى الشيخ زامل بعنوان: (عبد الله غيث، شخصيّة تأثرت بالحسين)، منشور في موقع منتدى الخالدين على شبكة الإنترنت: www.alkhaledoon.com.
[545] حسين الهلالي: الحوار المتمدّن، العدد: 2163، 17ـ1ـ2008: ـ03ـ10 عنوان الموقع:
http: // ahewar.org.
[546] المقرم، عبد الرزاق الموسوي، مقتل الحسين، دار الكتاب الإسلاميّ، بيروت، ط5، 1399هـ/1979م: ص264.
[547] الهاشمي، هاشم، موقع المشكاة http: //al-meshkah.com.
[548] الهاشمي، هاشم، موقع المشكاة http: //al-meshkah.com.
[549] الهاشمي، هاشم، موقع المشكاة http: //al-meshkah.com.
[550] ترجمة ما كتبه ملا حسين واعظ كاشفي في كتابه (روضة الشهداء)، عن عرس القاسم، مصدر سابق: ص220ـ223.
[551] ولد آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزيّ في العام 1345هـ في بيت دينيّ رفيع بمدينة تبريز في إيران، وفي العام 1371هـ سافر إلى مدينة النجف الأشرف، وحضر فيها دروس السيّد أبي القاسم الخوئيّ، والسيد عبد الهادي الشيرازيّ وبعد مدّة قصيرة صار من أبرز تلامذة السيد أبي القاسم الخوئيّ، وفي العام 1397هـ وبعد عودته من زيارة الإمام الحسين في مدينة كربلاء داهمته قوات أمن الرئيس المخلوع صدام حسين وسفّرته إلى إيران. عندها سكن مدينة قم المقدّسة وشرع بتدريس الدروس العالية لا سيّما الفقه والأصول. من مؤلّفاته: إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، يقع في أربعة أجزاء، صراط النجاة ويقع في ثلاثة عشر مجلداً، منهاج الصالحين، أسس الحدود والتعزيرات، أسس القضاء والشهادات، تكملة منهاج الصالحين، تنقيح مباني الأحكام، ويقع في ثلاثة أجزاء، تنقيح مباني العروة الوثقى، ويقع في أكثر من عشرة أجزاء، وقد طُبع منه حتّى الآن أربعة أجزاء. انتقل إلى جوار الرفيق الأعلى في يوم الاثنين 21 / 11 / 2006 وذلك في مدينة قم المقدّسة في إيران.
[552] التبريزي، آية الله العظمى الشيخ الميرزا جواد، الأنوار الإلهيّة، منشورات دار الصديقة الشهيدة، قم، ط1، 1422هـ: ص168.
[553] حسن، لطيف،
فصول من تاريخ المسرح العراقي، نقلاً عن موقع الناس علي شبكة الإنترنت:
http: //al-nass.com/culture/fnoon/2006.
[554] تشلکوفسكي، تعزيه: آيين ونمايش در إيران [التعزية: العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص25.
[555] بلوكباشي، علي، تعزيه خواني، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص124ـ125.
[556] في العصر القاجاريّ كان يطلق على الأستاد اسم آخر وهو (معين البكاء) الذي کان يقوم بدور مخرج المسرحيّة.
[557] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص126ـ127.
[558] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص130، 131.
[559] بلوكباشي، علي، تعزيه خوانى، حديث قدسى مصايب در نمايش آیینی [قراءة التعزية، حديث المصائب القدسيّة في التمثيل الدينيّ]، مصدر سابق: ص133ـ134.
[560] تعليق للدكتورة دلال عبّاس: يمكننا قراءة القصّة على أنّها أسطورة عاميّة مُتَخيَّلة، على أن ننسى أنّ أبطالها شهداء كربلاء، لأنّ الكلام الوارد لا يقبله عقل ولا منطق ولا دين.
[561] يستخدم كتاب التعازي في إيران عبارات مبالغ فيها للتأثير على المشاهد.
[562] همايوني، صادق، تعزيه وتعزيه خواني [التعزیه وقراءة التعزیة]، مصدر سابق: ص112؛ تشلكوفسكي، بيتر: تعزيه: آيين ونمايش در إيران [التعزية: العروض التقليديّة في إيران]، مصدر سابق: ص25.