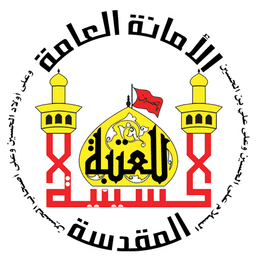المقدّمة
وإنّ تحديد الضابطة في الحكم على أهميّة تلك الأحداث يختلف بين أمة وأخرى، فأغلب الباحثين في التاريخ القديم يرون أنّ التحوّل الديني للمجتمعات في العالم، أو على الأقل للشعوب القاطنة في منطقة الشرق الأوسط، حدثاً مهماً في الحياة البشرية.
والمسلمون حالهم حال الشعوب الأخرى، ساروا ضمن هذه القاعدة؛ فرأوا أنّ بعثة النبي’ عام (611م) أهمّ حدث سجّله تاريخهم؛ لأنّه نقل حياتهم من التسلط بالقوة والجور والعبودية والعصبية القبلية، إلى حضارة تختلف عمّا سبقها اختلافاً كبيراً.
فقد شكّل الإسلام في بدايته، نقطة تحوّل عظيمة، في سلوك المجتمع، وحياته الاجتماعية والثقافية والدينية والسياسية والفكرية، وفي بناء شخصية الفرد ومقاييسه، ونمط تفكيره ضمن الجماعة.
ثمّ اعتبر غالبهم أنّ حادثة السقيفة التي جرى الاختلاف فيها حول الإمارة ـ بعد رحيل الرسول الكريم’ في السنة الحادية عشر من الهجرة ـ أولى الوقائع وأعظمها أثراً في التاريخ الإسلامي.
بل شكّلت منعطفاً بالنسبة إلى الكثير من الأحداث والاتجاهات اللاحقة للمسلمين كافة، ما زال النظر المتفاوت إليها، يمثّل فرقاً جوهرياً، في أسلوب تفكير كلّ فرقة تجاهها.
ولم يعرف تاريخ المسلمين، حادثة صدّعت المجتمع، وشتّت شملهم، ومزّقته إلى نصفين، مثل حادثة مقتل عثمان بن عفان، على أيدي جماعة من رعيته حتى ذكرت بعض المصادر أنّ فيمن قتله الصحابيين عبد الرحمن بن عديس البلوي الرضواني، وعمرو بن الحمق الخزاعي الشجري، ففتحت هذه الحادثة باب الاجتهاد بالسيف على مصراعيه؛ تطبيقاً لمبدأ حق الأمّة في محاسبة الحاكم، وواجه المسلمون أخطر تحدٍّ لهم في تاريخهم.
وفي إجراء سريع لحماية الدولة من الانهيارات الاجتماعية والسياسية والفكرية وغيرها، سارع أصحاب رسول الله’ ـ وعلى رأسهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ـ إلى تأمير علي× عليهم، وأخذ البيعة له من المسلمين في سائر البلاد. ويبدو من المصادر نفسها أنّها المرّة الأولى للمسلمين في تاريخهم، مارسوا فيها الحرية في انتخاب الحاكم؛ إذ لم تُسجّل كتب التاريخ أنّهم تنازعوا على السلطة عند البيعة له.
إلّا أنّ الحرية التي اتبعها علي× في انتخابه أميراً لهم، ورغبته عن النفع المادي المرتجى من الإمارة، كما صرّح بذلك في أكثر من مناسبة، جعلت أجلّ مبايعيه أن يقودوا معارضة مسلّحة ضد السلطة المركزية في المدينة المنورة، التي قد تغيّر نظامها خلال العقود المنصرمة، فأركب طلحة والزبير أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر جملاً وسارا بها نحو البصرة سنة (36 ﻫ)، وانتهى الأمر بمقتلهما مع نحو من عشرة آلاف، وجرحى لا يُحصون كثرةً.
وما لبثت أن هدأت تلك المواجهة المسلحة، التي قادتها عائشة، بانتصار الدولة الإسلامية، حتى نادى الصحابيان معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص، بالاستقلال التام عنها، وتحصّنا في الشام ومصر، ونقل الإمام علي× عاصمة الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة.
وبدأ الصحابيان بشن المعارك الضارية على الدولة المركزية.
فراحت ضحيتها ستون أو سبعون أو تسعون ألفاً.
وكان من جملتهم خمسة وعشرون بدرياً، وثلاثة وستون رضوانياً، منهم عمّار بن ياسر.
وبعد أن رأى معاوية أنّ السيوف وحدها لن تنجيه من قبضة الدولة المركزية، لجأ إلى استخدام خدعة رفع المصاحف على أسنّة الرماح، معتمداً على مشورة عمرو بن العاص له، بوقف القتال.
فجاء نحو عشرين ألف مقاتل من جيش عليّ، حاملين سيوفهم على عواتقهم، وقد اسودّت جباههم من السجود، يتقدّمهم عصابة من القرّاء، إلى عليّ، ونادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين، وقالوا له:
أجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت، وإلّا قاتلناك.
وكان إقحام المصاحف في الحروب والسياسة سابقة خطيرة، لم يكن المقصود منها الاستناد إلى حكم الله، بقدر الخروج من مأزق عسكري، ونجاة فصيل من الهزيمة، وتوافق الطرفان على الهدنة والتشاور.
ثمّ تغيّر حال أهل الجباه السود سريعاً، فأحدثوا شروخاً عميقة في المحجة البيضاء للأمة التي تركها الرسول’.
والملاحظ في هذه الأحداث جميعها، عدم وجود آلية دينية واضحة، مستوحاة من الكتاب الكريم وسيرة النبي’ لدى الصحابة والتابعين الذين خرجوا على الحكومة الإسلامية المركزية، بل كان خروجهم العسكري ضد الحكومة المركزية، مخالفة صريحة لنصوص الكتاب الكريم التي لا غبار عليها بنسخ أو تأويل.
وبعد معاهدة الإمامين الحسن والحسين‘ وأتباعهما مع معاوية، آلت قيادة الأمّة الإسلامية إليه، حيث أسّس لأيديولوجيا الجبر الإلهي التي صارت فيما بعد فلسفة الأمويين من أجل تبرير حكمهم الفردي، وسياستهم العنيفة ضد الشعوب المسلمة، واستحدث مبدأ نظام التوريث في شكل النظام السياسي؛ حتى وصل الحال ببعض فقهاء الأمّة حينها، أن اعتبروا هذين الأصلين، هما القاعدة في تشريع نظام الدولة.
وهذان المبدآن اللذان أصرّ معاوية على استخدامهما، جعلا الحكومة الإسلامية حكومة فردية دكتاتورية، قائمة على حساب تطلع المجتمع، الذي ناضل قبل عقود قليلة، من أجل إرساء المنظومة الإلهية الفكرية، التي جاء بها محمّد’ فيه، بعد أن كانت المنطقة العربية والمناطق المجاورة تزخر بالصراعات والمعارك الدينية والقبلية والقومية، وتعاني منها.
فأفرزت نماذج فكرية جديدة في الواقع الإسلامي، غيّرت بمرور الوقت البنية الفكرية المجتمعية له.
ففي الوقت الذي يرى فيه غير واحد من الباحثين أنّ جذور مسألة القدر بالتفسير الأموي ترجع إلى عبد الله بن صبيغ، الذي أثارها في إمارة عمر بن الخطاب، أو أنّ أساسها يرجع إلى حرب معاوية والخوارج ضد الدولة الإسلامية، تذكر المصادر والمراجع التاريخية أنّ معبد الجهني وغيلان الدمشقي كانا من أوائل الذين نادوا بالقدر بالمعنى الذي يحمّل السلطة الأموية، مسؤولية أعمالهم المشينة، وما ترتّب عنها من جرائم عظيمة سوّدت وجه الحضارة الإنسانية.
فاستهزاء الأمويين بالعقل الأخلاقي للأمّة، وإقصاء الفكر المحمّدي المشرق وحامليه من أهل البيت والأصحاب، وتسخير مقدرات الدولة لصالح سياساتهم، هو الذي أثار ردود الفعل النقدية.
والتي اتخذت تلك الردود أشكالاً مختلفة، فمنهم من رأى أفضلية المعارضة العلمية، على الالتحاق مع منظومة التكفير التي تبنتها الخوارج، أو مع المعارضة السياسية القصوى، التي تبناها: الإمام الحسين× وجمع معه، وأهل المدينة المنورة، وعبد الله بن الزبير، والتوابون، والمختار، وبنو العباس، وزيد بن علي، وابنه يحيى، وغيرهم.
ورغم تفرّد السلطة الأموية بكل وسائل الإعلام المتاحة آنذاك، فإنّ هذه الأحداث لم تمرّ على المسلمين مرور الكرام، بل اهتموا بها اهتماماً بالغاً.
إلّا أنّ الذي يظهر هو أنّهم كانوا يُفضّلون عنايتهم بالرواية الشفهية، على وفق نظام الإجازة من الراوية، حتى بعد الحقبة التي دوّن فيها المؤرخون تواريخهم؛ لامتياز العرب عن غيرهم بكثرة الحفظ وقوة الذاكرة، التي كانت تلبي حاجات تطورهم الحضاري، ولخوفهم من الانتحال والتزوير والوضع، وللحفاظ على أهمية وفائدة وقيمة الأستاذ الراوية.
فاستمر الحظر على تدوين الفنون التاريخية في الأمّة، إلّا ما ندر.
ومهما تكن الأسباب، فقد أصبحت هناك حاجة ماسّة إلى معرفة سيرة أشرف الخلق’ وأحواله، الأمر الذي جعل أن يظهر من يجمع أخبار تلك السيرة العطرة ويدوّنها.
فكان أوّل من كتب فيها كما تؤكّد المصادر التاريخية، هو عروة بن الزبير بن العوام (712م)، وإبان بن عثمان (723م)، ووهب بن منبه (732م).
إلّا أنّ أشهر من كتب في السيرة والمغازي هو محمّد بن إسحاق حوالي (768م)، والذي اختصر سيرته ابن هشام (833م)، في كتابه المشهور، والذي شرح واقتصر أكثر من مرة فيما بعد.
وبعد امتداد أطراف الدولة، اهتم المسلمون باستقصاء أخبار الفتوح وتدوين حوادثها، فنشأ التاريخ العربي الإسلامي نشأة طبيعية، كانت بصورة أكيدة، استجابة لحاجة المجتمع.
وهناك آراء كثيرة حول ظهور علم التأريخ بصيغته العلمية عند المسلمين، فمنهم من يرى أنّ ابن خلدون هو المؤسّس الأوّل لعلم التأريخ، بتلك النظرة الغربية الحديثة له، التي تجعل منه عالماً غربياً بامتياز، مع عدم الالتفات إلى كونه عربياً مسلماً حضارة وثقافة؛ فما جاء في المقدمة، هو نتاج تميّز شخصي حاز عليه، وليس له امتداد تاريخي في الحضارة الإسلامية، وإنّما نشأ فريداً غريباً.
ولذا كان الغربيون هم أوّل من اهتموا به، ولفتوا النظر إليه؛ لأنّ العرب لم يكونوا ليفهموا هذا العلم الحديث؛ كونه ليس علمهم، بل هو علم غربي، حتى إنّهم لم يستفيدوا من كتابات ابن خلدون، فعلم التاريخ عندهم لم يتغير بعده كثيراً، إذ ظلّ التغيّر قاصراً على ظهور كتب الخطط، أمّا كتب التاريخ ـ كتاب السخاوي مثلاً ـ فقد ظلت على ما هي عليه قبل ابن خلدون، ولم تؤثر عليها الكتابات الخلدونية.
ومنهم من يذهب إلى أنّ المسلمين ليسوا في حاجة لعلم تأريخ من الأساس؛ ذلك لأنّ العلم الذي استعمله المسلمون واعتمدوا عليه في معرفة الصواب من الخطأ التاريخي، كان هو علم الإسناد، وهو العلم الذي لم يوجد لدى أحد من الأمم بهذا الشكل والحجم من قبل.
فعلم الإسناد بما يتبعه من علوم: الأنساب والجرح والتعديل والرجال والطبقات والوفيات، لم يُحوج المسلمين إلى الاعتناء كثيراً بعلوم نقد المتن، وإن كان هذا لا يعني عدم وجودها البتة بطبيعة الحال.
فشروط الرواية والرواة، ستظل هي عماد منهاج النقد عند المسلمين في جميع أطواره، وإن اختلفت درجة الاحتكام إليها من طور لآخر، من حيث التشدّد أو التساهل.
ومنهم من يجمع بين علمي التاريخ ومصطلح الحديث.
فيرى أنّ أوّل من نظم نقد الروايات التاريخية ووضع القواعد لذلك، هم علماء الإسلام، ولم يكن بإمكان كبار المؤرخين في أوروبا والغرب، أن يكتبوا أفضل مما كتب علماء المصطلح، وإنّ مباحث تحري الرواية والمجيء باللفظ وغيرها، تضاهي ما ورد في الموضوع نفسه، مما كتبه الغربيون في عصرنا الحديث.
وإنّ التاريخ ليس مجرد نقل للرواية والأسانيد، بل علم له أصول وقواعد كعلوم الطب والفقه والهندسة، وهذه الأصول تتلاقى في كثير من الأمور مع أصول علم الحديث المتمثلة في علم المصطلح.
ولا شكّ في أنّ أحد أهداف دراسة التاريخ هو خدمة الحاضر والمستقبل.
فلا معنى للاهتمام بوقائعه والغوص في تفاصيله إذا لم يكن مفيداً للحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نطمح إليه؛ لأنّ الماضي قد طويت صفحته بكل ما فيه من نجاحات وإخفاقات، وانتصارات وانكسارات، وإيجابيات وسلبيات، ولم يعد بإمكاننا تغيير أي شيء من وقائعه، أو تعديل أي مفصل من مفاصله.
فعلينا أن نستفيد من دروسه وعبره في تغيير حاضرنا، ورسم معالم مستقبلنا، وإلّا ستبقى قراءتنا للتاريخ ضرباً من التسلية، وفي أحسن الأحوال نوع معرفة لما جرى في العصور السالفة.
فإنّ أسوأ ما في قراءتنا للتاريخ، هو أنّ بعضنا ينتقي جملة من الوقائع المتقادمة، ويكتشف من خلالها مداخل لخلافات معاصرة، تتبدد فيها طاقة الأمّة وقدراتها، وتتعزز معها خلافاتها، دون أن تتمثّل هذه القراءة في أعمالنا وسلوكنا؛ لأنّ وقائع تاريخنا القديم أعظم وأوسع من أن تختزل في واقعتين أو ثلاث.
ولأنّ المقدّمة تأخذ على عاتقها بيان الإطار العام للأطروحة؛ جاءت في مجموعة مباحث كالآتي:
موضوع الدراسة
من الوقائع التاريخية التي احتلّت حيّزاً مهمّاً على أشكال مختلفة من الاهتمام، حوادث النهضة الحسينية.
فقد انكبّ الباحثون عليها، بحثاً وتأليفاً وتحقيقاً وتحليلاً ودراسة وعرضاً، منذ حدوثها؛ لعدم اعتبارها مجرّد حادثة وقعت وانتهت، بل محطّة عظيمة للمسلم وغيره نظراً لما يلي:
1 ـ الأبعاد الأخلاقية والإعلامية والتربوية والسياسية والعبادية والعسكرية والغيبية التي تفرّدت بها.
2 ـ تغلغلها في أعماق الوجدان الشعبي للأمّة؛ إذ باتت جزءاً من الجوّ الثقافي العام لها.
3 ـ أنّها ما زالت تُسهم بدور مهم في تكوين شخصية المسلم الثقافية وأخلاقياته الاجتماعية والسياسية.
4 ـ كونها واعزاً وحافزاً لما تلاها من نهضات اجتماعية وفكرية وسياسية وغيرها.
وجذبت نحوها العديد من الأطروحات، التي تنتظم في طيف متنوع من الرؤى التاريخية والسياسية والفقهية والكلامية وغيرها، ينتهي إلى تهيئة نتاج وافر وثري يتناولها.
وانطلقت الأطروحة السلفية، التي أسّسها معاوية بن أبي سفيان وشيعته، وتبنّاها الإعلام الأموي، ومن سار بركبه، على مرّ العصور السالفة، والسنين المعاصرة؛ من مبدأي الجبر، وصحة نظام الحكم الفردي الوراثي.
فقرّرت في بعض الأحيان أنّها خروج على خليفة شرعي لرسول الله’ يحرم الخروج عليه.
ويبدو أنّ دوافع هذه الأطروحة كانت سياسية؛ لعدم قبولها إلّا من أفراد قلائل، ساروا في ركب الأمراء؛ طمعاً في دنياهم، أو تقية من سطوتهم.
فظهرت بدايتها سياسية محضة، ثمّ تحوّلت فيما بعد إلى مسألة فقهية، أصّل لها البعض، على وفق بعض القواعد التي دوّنوها لاحقاً، في ظل الاضطرابات السياسية المعقدة.
وهذه الآراء الأموية نوقشت من محورين:
الأوّل: تكفير من خرج على معاوية والدولة الأموية، من أهل البيت^ والصحابة الكرام، إلّا أنّ هذا الرأي ظل صامتاً في أروقة الحكومات، ولم ينتقل إلى أهل العلم آنذاك؛ لأنّ الغاية التي كانت منه، هي تثبيت الحكم الأموي.
ولذلك لم ينقل بشكل واضح عن الإمارة الأموية التي أقيمت في الأندلس.
ويبدو أنّ السبب في موت هذا الرأي، هو جلالة من خرج على الدولة، وتفهم الصحابة لمبادئ الإسلام.
الثاني: تصحيح خلافة الأمراء الأمويين؛ بحجّة أنّ الواقع السياسي قد فرض إمارة معاوية، أو إمارة يزيد، والخروج على أحدهما، يعني تخريب النظام العام، الذي يؤدّي إلى فناء الدولة الإسلامية.
وهذا المبدأ أصّل له مَن تأثّر بإعلام بني أمية، والكلمات التي نسبوها للنبي’، ولأصحابه الكرام.
فالذي صحح خلافة يزيد ومَن جاء من بعده، جعل الأصل معه، واعتبر الإمام× والصحابة الذين معه، وصحابة المدينة المنورة، والصحابي عبد الله بن الزبير خارجين على الشرعية المتمثّلة بالحكومة العهدية آنذاك.
وهذا الضد بين نظرية الإمامية ـ التي ترى أنّ سكنات وحركات الإمام الحسين× حجة شرعية، مصدرها الوحي الإلهي ـ وبين السياسة التكفيرية؛ جعل البعض أن يجعل الأصل الشرعي مع الاثنين، فالإمام قد نصّ عليه رسول الله’، ويزيد قد نصّت على شرعيته كتب السلف، المستوحاة من الكلمات الموضوعة على رسول الله’، ومن الارتباك السياسي الذي حدث في تلك الفترة الحرجة على الأمّة الإسلامية.
ويبدو أنّ الفقيه محمّد بن عبد الله بن العربي، المتوفى سنة (543ﻫ، 1148م)، هو أوّل من صرّح بهذه النظرية، في كتابه: العواصم من القواصم، في تحقيق مواقف الصحابة، بعد وفاة النبي’ الذي صنّفه لأجل الردّ على بعض الفرق الإسلامية، وسار على نهجه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المتوفّى سنة (728ﻫ، 1328م).
ولتعرض هذه النظرية للانتقاد اللاذع من الفقهاء، على مر العصور ـ مع ملاحظة أنّها دوّنت مع وجود الطمع أو الخوف الشديدين ـ انحدرت انحداراً عظيماً، حتى إنها تكاد لا تذكر.
إلى أن ظهرت الدولة الوهابية المؤدلجة أموياً، فأنهضها بعض المعاصرين، نظير: محمّد الخضري بك، المتوفّى سنة (1345ﻫ، 1927م) في كتابه: الدولة الأموية، فجعل الخطأ ليس في أصل الخروج على الشرعية، وإنّما في المقدمات والاستعداد العسكري للحرب.
وتبنّي بعض السلفية المعاصرة لهذه المنظومة المتطرّفة، في انتزاع نظام الحكم بالقوة وإعادته للفردية الفكرية، على وفق مبدأ الدولة الأموية، إنّما هو رفض تام للمدنية الحديثة، وتهديد لما توصلت إليه القيم الإنسانية، والتعايش السلمي بين أصحاب الأديان السماوية وغيرها، وتحويل طاقات الأمّة الشبابية إلى مجموعات ضارة، من خلال الالتحاق بالجماعات الإرهابية، التي تقاتل الحكومات، في عدد من البلدان الإسلامية، مثل: أفغانستان وسورية والعراق وليبيا واليمن.
ونظراً لتمسّك أغلب المسلمين بأهل البيت^، وبالإمام الحسين× خصوصاً، مع القفزة النوعية في انتشار وسائل القراءة، لجأ أنصار الخط الأموي المتمثّل بالسلفية السعودية ـ ولعلّه لأسباب سياسية، مرتبطة بخوفها من توسع الشيعة في ثلاثة محاور محيطة بها، خصوصاً بعد ظاهرة الربيع العربي، وتهديم البنى التحتية في ليبيا ذات الطبيعة القبلية، التي تُحدّ بحدود صحراوية طويلة، مصر الحضارة، ومناقشة إعادة علاقة الأخيرة بإيران، ودعم الشيعة للمقاومة في لبنان وفلسطين، وانتشار التشيع بشكل لم يسبقه مثيل في المغرب العربي ـ إلى تثقيف المجتمع الناشئ بأسلوب آخر، يجمع بين حب الحسين× وتصحيح ثورته، وحب يزيد وتصحيح خلافته، في آن واحد.
فوقع الاختيار على الدكتور الصلّابي المتخرّج عام (1993م) في البكالوريوس، أو درجة الإجازة من كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة المدينة المنورة، السلفية التوجه؛ ليعيد صياغة الأحداث التاريخية بما يتلاءم مع الفكر الأموي، الذي أكل الدهر عليه وشرب، فيجرّون شبيبة الأمّة، وخصوصاً في البلدان المضطربة اقتصادياً وسياسياً، إلى متاهة الحكم الفردي الأموي، الذي قهر العباد ونهب البلاد، مسخّرة كافة الإمكانات المادية له التي تتمتع بها هذه الفرقة.
لهذا جاءت هذه الدراسة لتبيّن رؤية (الفكر السلفي) تجاه (النهضة الحسينية) ضد حكومة يزيد، التي فرضها الواقع على الأمّة، وتدرسها دراسة تاريخية تحليلية مقارنة نقدية؛ متّخذة الدكتور (الصلّابي) أنموذجاً للفكر السلفي المعاصر فيها؛ لما يلي:
1 ـ تمثيله الواسع للفكر الأموي في المحافل الإقليمية والدولية.
2 ـ سعيه للفرار من تهمة النصب لأهل البيت والصحابة.
3 ـ محاولته الابتعاد عن تخطئة النهضة الحسينية، التي يتبنّاها الفكر السلفي الأموي التقليدي.
4 ـ مداراته للمدرسة الأشعرية في دراسته لها.
5 ـ مناورته في دراسة النهضة الحسينية، بين المدارس الفكرية.
6 ـ نظرته الشمولية لتاريخ النهضة الحسينية.
فاستقرأت الدراسة الفكر السلفي، منذ تأسيسه وطرحه في الساحة، إلى الوقت الحاضر، وخلصت إلى أنّ مناقشة السلفية للنهضة الحسينية تمخضّت عنها مجموعة شبهات.
تبدأ من معاهدة الإمام الحسن×، باعتبار أنّه قد اشترك بهذه المعاهدة، وتمرّ برفض الإمام× البيعة ليزيد، ومسيره نحو العراق، وتنتهي بمقتله× يوم عاشوراء.
فجعلت الدراسة الأساس التي انطلقت على وفقه، المراحل التاريخية الآتية:
المرحلة الأُولى: مرحلة المعاهدة مع معاوية
وتتمثّل بعدم وفاء معاوية بعهوده التي قطعها للإمامين. وهذه المرحلة، اعتبرها بعض المحققين مقدمة للنهضة الحسينية وليست داخلة فيها؛ لأنّ المواقف المعارضة لشيعة الحسين× كانت مخالفة لما اتفق عليه الطرفان، كما إنّ عدم التزام معاوية بها لا يعني بالضرورة جواز خرمها من قبلهم؛ لعدم وجود النص الصريح ببطلانها مع تخلف معاوية، ولأنّ جميع طوائف المسلمين ـ حسب الاطلاع ـ التي قالت بحجية سيرة الإمام×، أو على الأقل بصحة عمله، لم ترَ حدوث المعارضة العسكرية لمعاوية، سوى الإعلامية أو الشرعية.
المرحلة الثانية: مرحلة رفض بيعة يزيد
وتتمثّل برفض الإمام الحسين× لإمارة يزيد وبيعته بعد موت معاوية، واستلامه للسلطة عملياً، والإصرار على عدم بيعته له في المدينة المنورة عندما طلب حاكمها جملة وتفصيلاً ـ ولو كانت بشرط كما فعل أخوه× مع معاوية ـ وسفره من المدينة المنورة نحو مكّة المكرّمة.
المرحلة الثالثة: مرحلة الإعداد للنهضة
وتتمثّل بخروجه من مكّة المكرّمة الآمنة، بعد أن أعطى حاكمها الجديد عمرو بن سعيد الأشدق الأمان له، بتدخّل ابن عمه عبد الله بن جعفر، ونصحه الناصحون من الصحابة وغيرهم بعدم الاغترار بكتب أهل الكوفة، والركون إلى بيت الله الحرام، كابن الزبير، والتوجه إلى العمل في الزراعة.
وهذه المرحلة ربما يعتقد بدخولها في المرحلة السابقة، إلّا أنّ مجرد التفكير بالنهضة يعد خروجاً؛ فإنّ العهد الذي عهده الإمام الحسين× في الصلح، قد انتهى بموت معاوية، وإنّ إرادة يزيد حصرت في البيعة المصحوبة بالرضا بقضاء الله، فعليه أن يسكت أنواع المعارضات الإعلامية والدينية جميعها، فضلاً عن المسلحة.
والبحث في هذه الدراسة وإن كان منصباً على النهضة الحسينية تاريخياً، إلّا أنّه لاحظ أيضاً المسائل الدينية، موضع النزاع، فتناولت علوم الحديث والرجال والعقيدة والفلسفة والفقه والكلام وغيرها، في الموارد التي تستدعي الخوض فيها؛ لأنّ النظرة السلفية ـ وبصورة خاصة الصلّابي للنهضة الحسينية، تستبطن الطعن على عقائد المسلمين، بمختلف مشاربهم ومذاهبهم الفقهية، من الإمامية الاثني عشرية والزيدية وأهل السنّة وغيرهم. وهو الأمر الذي يمثّل خطراً عظيماً على وحدة الأمّة، تجاه ما تواجهه من تحديات تستهدفها، من دول الاستكبار العالمي ذات الفكر الصهيوصليبي.
الدراسات السابقة
تناول النهضة الحسينية بالبحث والتحقيق، علماء الفقه والقانون والمحدّثون والمحقّقون والمفسّرون والمؤرّخون وغيرهم، إلّا أنّ البحث كان فيها عندهم بصورة عامّة، أو في مواضيع محدّدة.
ومن الدراسات التي تناولت النهضة الحسينية ضمن الفكر السلفي، الذي يتبناه الصلّابي، ما يلي:
1 ـ الأدلة على تورط يزيد بدم الحسين×، محمّد صنقور حيدر، مرفوع على المكتبة الشاملة الرقمية.
يقع الكتاب في (125) صفحة، ويتناول موضوعاً واحداً فقط، أثبت فيه أنّ يزيد هو الذي أمر بقتل الإمام الحسين×. والكتاب مستوحى من مقولات السلفية التي تُبرّء يزيد من أمره بقتل الإمام×.
وقد تناولت الدراسة هذا الموضوع بصورة تفصيلية اعتماداً على ما قاله الصلّابي.
2 ـ تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي، صائب عبد الحميد، ط2، دائرة معارف الفقه الإسلامي، قم، (2005م).
يقع الكتاب في (876) صفحة. وطبعته الأُولى، دار الغدير، بيروت، (1997م).
وتناول الردّ على محاولات تزييف النهضة في الفكر السلفي ـ التي ذكرها أيضاً الدكتور الصلّابي ـ عموماً، فهو لم يتعرّض للردّ على الصلّابي بل لشبهات السلفية، وفيها تأكيد على نقد مبدأ التوريث في نظام الحكم فقهياً.
وقد تناولت هذه الدراسة، نقد مبدأ توريث الحكم فقهياً اعتماداً على ما أصّل له السلفية، وما ذكره الصلّابي.
3 ـ الحسين× في مواجهة الضلال الأموي، سامي البدري، ط2، طور سينين، بغداد، (2009م).
يقع الكتاب في (527) صفحة، وقد أكّد في: ص156 منه، أنّ هدف وخطة الإمام الحسين× هما: أن يهاجر إلى بلد النصرة والحماية؛ ليقوم بتوعية أهله بأحاديث النبي’ صحيحة، وإقامة العدل فيهم. ثمّ جهاد السلطة الأموية، وتطويق سياستها الضالة الظالمة، ومن ثمّ الإطاحة بها.
وقد تمثّل هذا البلد بالكوفة، حيث وُجد فيها أنصار للحسين× قادرين على حمايته، ويقاتلون دونه. فاختلف مع الصلّابي في أنّ الصحابة قد أوضحوا له بأنّ الخطة المرسومة آيلة للفشل، وألا يتخذ من الكوفة مقراً لدعوته، ولا من أهلها أنصاراً له.
4 ـ الحسين، من قتله؟ شيعة الكوفة؟، علي الحسيني الميلاني، ط1، مركز الحقائق الإسلامية، قم (2010م).
يقع الكتاب في (207) صفحة، وهو في الأصل بحوث مقررة؛ للتعريف بالفكر الشيعي، بالبراهين العقليّة المتقنة والأدلّة النقلية من الكتاب والسنّة، من أجل ترسيخها في أذهان المؤمنين، ودفع بعض الشبهات المثارة حولها، فتناول أنّ يزيد هو الذي أمر بقتل الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه.
وهو رد بالجملة على قراءة الفكر السلفي للنهضة الحسينية، وإن لم يتناول مقالات السلفية والصلّابي، مع ملاحظة أنّ الصلّابي أقرّ بمسؤولية يزيد، دون أمره بقتل الإمام×.
وقد تناولت هذه الدراسة، هذا الموضوع بصورة تفصيلية اعتماداً على ما قاله الصلّابي.
5 ـ حوار هادئ مع الدكتور القزويني الشيعي الاثني عشري، للدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي، ط1، مكتبة الملك فهد الوطنية، مكّة المكرّمة، (2005م).
يقع الكتاب في (393) صفحة، وهو في الأصل حوار شفهي دار بين الحسيني القزويني والغامدي، ثمّ قُرّر تحريرياً، وأما كتاب (قصة الحوار الهادئ) للسيد القزويني فقد تناول فيه الردّ على أن أفعال معاوية ويزيد المشينة لا تخالف مبدأ عدالة الصحابة. وهو ردّ بالجملة على قراءة الفكر السلفي للنهضة الحسينية، في ضوء مبدأي شرعية ولاية العهد ليزيد.
وقد تناولت هذه الدراسة، هذا الموضوع بصورة تفصيلية في أكثر من موضع؛ اعتماداً على ما قاله الصلّابي.
6 ـ رد الأباطيل عن نهضة الحسين، عبد الله دشتي، ط2، (2008م).
يقع الكتاب في (83) صفحة، وهو ردّ على بعض منشورات السلفية التي وقعت بيده، فتناول: الرد على الآتي:
تقييم ابن تيمية وأفارخه للنهضة الحسينية، ونصيحة الصحابة للإمام الحسين× بعدم الخروج إلى العراق، وأنّ الشيعة هم الذين قتلوه، وهمّه بالرجوع من العراق، وأنّه× قال: «أضع يدي في يد يزيد»، وأنّ الجيش الأموي لم يمنعه من الماء، وأنّ يزيد بريء من دم الحسين×.
وأصل هذه المقولات لابن تيمية، نقلها الخضري والصلّابي عنه، إلّا أنّ كاتب المنشورات قد حذف من كلام ابن تيمية، والكاتب اعتمد على ما جاء فيها، وردّها بالجملة.
وقد تناولت هذه الدراسة، هذه المواضيع بصورة تفصيلية اعتماداً على ما قاله ابن تيمية والخضري والصلابي.
7 ـ النهضة الحسينية، مرتضى مطهري، مطبوعة ضمن: مجموعه آثاره، ج17، ط6، انتشارات صدرا، طهران، (2003م).
وقد تناولت الدراسة التحريف الذي طرأ على واقعة كربلاء، من خلال إدخال المفاهيم الخاطئة.
فهو ردّ إجمالي على الأفكار الخاطئة ـ في نظره ـ كافة من السلفية وغيرهم.
ولم يتناول الدكتور الصلّابي؛ لفارق الزمن بينهما.
أهمّية الدراسة
إنّ المتابع لأدبيات المدرسة السلفية المعاصرة، يلمس بوضوح محاولتها تطبيق الفكر الأموي في المجتمع؛ إذ إنّ بصماته تصبغ الملامح العامّة لتنظيراتها وممارساتها العملية على الساحة، وهذا الانطباع من الناحية التاريخية لا يعدّ تأثراً فكرياً مجرداً، أنتجته العفوية والصدفة، بل إنّما يعكس ارتباطاً عضوياً، مثّلت فيه السلفية المعاصرة الامتداد التاريخي والطبيعي للدولة الأموية وأفكارها وسياساتها العامّة تجاه المجتمع.
ورغم أنّ كثيراً يرون أنّ الفكرة السلفية قد جمعت مدرستي النواصب البصرية والشامية، وحملت لواء أحمد بكل ترسباته الفكرية والعقدية، وتبلورت على ابن تيمية في القرن السابع الهجري، الذي كفّر: الإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية، وباطنية الشيعة، وباطنية الصوفية أصحاب وحدة الوجود، والجهمية الباطنية والفلاسفة والقدرية والنصيرية أهل الجبل، وأصبحت كتبه وفتاواه، وكتب أحبابه وأنصاره وتلامذته ومحبيه، الذين أوذوا في سبيل نصرة عقيدة شيخهم، أمثال: ابن القيم وابن كثير والذهبي والمزي وابن عبد الهادي، هي المصادر المعتمدة لها.
ويرون كذلك أنّها اتخذت السلفية الوهابية ـ التي خرجت من رحم السلفية التاريخية في مطلع القرن الثامن عشر، وتحالفت مع أمير الدرعية ابن سعود؛ لتكوّن الأساس الأيدلوجي لتوحيد المملكة السعودية، أنموذجاً حقيقياً في بناء هذه الأيديولوجية الأموية المعاصرة وتطبيقها.
إلّا أنّ السلفية الحديثة، ورثت الأفكار الأموية والحنبلية والتيمية وأدبياتها، وسعت إلى أن تضعها في قوالب أيديولوجية، تعمل على تطويرها وترسيخها في الأجيال الناشئة، والتربص بالفرص المناسبة لإخراج هذه الأيديولوجيا، إلى مسرح العمل الميداني، بعد أن كانت حبيسة الكتب والتنظيرات.
بل إنّ الاطلاع على نظرة المدرسة السلفية المعاصرة إلى النهضة الحسينية، ضد الدولة الأموية تكشف جانباً مهماً من العمل السلفي المعاصر في أدلجة تلك الأفكار.
فهي تركّز ـ كما يفعل الصلّابي ـ بشكل كبير في عقول أبنائها أنّ شيعة العراق آنذاك يتحمّلون المسؤولية عن قتل الإمام وأهل بيته وأصحابه^؛ مستندة في ذلك إلى حقيقة أنّ أهل الكوفة هم الذين دعوا الإمام× للخروج، وأظهروا استعدادهم للبيعة والطاعة، فلمّا قدم العراق نكثوا العهد والمواثيق، وقتلوا الإمام وأهل بيته وأصحابه في واقعة كربلاء الأليمة.
وإنّ هذه الحقيقة المفاجئة ـ على وفق منهجهم ـ مقررة في كتب الشيعة أنفسهم.
وهذا المسلك، ظاهره ـ ولأوّل مرة ـ مقبول، بالنسبة للذين لم يطلعوا على تفاصيل التاريخ الدقيقة، وهم الأعم الأغلب من الأمة؛ إذ إنّ بيان حقيقة النهضة الحسينية، باعتبارها مسألة دينية قبل أن تكون بأبعادها المتعددة موكولة إلى الذين لهم نصيب من الدراسة الدينية التقليدية، أو الأكاديمية الحديثة المتخصصة.
إلّا أنّ دراستها بصورة تفصيلية عميقة، تظهر أنّه مبني على المبدأين اللذين سنّهما معاوية في الأمّة، ليكونا في آخر المطاف سببين رئيسين في تفرقة الأمّة الإسلامية، وفي القضاء على الدولة الأموية، بشعبتيها السفيانية، والمروانية.
فرضية الدراسة
النهضة الحسينية في الفكر السلفي، قرأت على وفق مبدأي الجبر في الحكم وصحة نظام التوريث في نظامه خروجاً على الشرعية، أمّا عند الصلّابي فإنّها خطأ في التقدير؛ لأنّه يوجّه اللوم نحو الإمام الحسين× بصورة موسعة تارة، ونحو يزيد بن معاوية بصورة مختصرة تارة أخرى، الأمر الذي يجعل المتلقّي أن يعتبرهما متعادلين، من حيث الدين والصحبة والعقل والنسب، مع أنّ الصحابة والتابعين من أهل السنّة صرّحوا بامتياز الأوّل بخصوصيات لم يمتز بها أحد من أهل البيت الأطهار والصحابة الكرام، سوى أبويه وأخيه^.
أهداف الدراسة
1 ـ تقرير ونقد الفكر السلفي حول وفاء معاوية للأمة، على ضوء معاهدة الإمام الحسن×.
2 ـ تقرير ونقد الفكر السلفي الرافض حول رفض الإمام× بيعة يزيد، بعد استلامه السلطة.
3 ـ تقرير ونقد الفكر السلفي الذي برّأ يزيد من دم الإمام×.
الجديد في الدراسة
ظهر الجانب الإبداعي للدراسة، في تسليط الضوء على تفسير السلفية المعاصرة، ذات التوجّه المخفّف، المتمثّل بالدكتور الصلّابي، للأحداث التاريخية التي حدثت في العالم الإسلامي بشكل عام، والأحداث التاريخية للنهضة الحسينية بشكل خاص، وما رافقت ذلك التفسير من إسقاطات الثوابت السلفية على عرض وتفسير التاريخ بنوعيه.
المنهج المتبع في تدوين الدراسة
اتخذت هذه الدراسة في تدوينها، المنهج الوصفي التحليلي المركّب من العرض والتحليل، منهجاً؛ فبعد استقراء المعلومات المناسبة للبحث من مصادرها ومراجعها الأصل، وتبويبها، وتقريرها، تم تحليلها والاستنتاج منها للوصول إلى الأهداف المرجوّة منها على وفق الترتيب الآتي:
1 ـ بدأ الطالب الباحث بتتبع مقولات السلفية، في كتبها الأصل، والكتب التاريخية والرجالية والكلامية وغيرها، التي اعتمدوا عليها، في بحوثهم، حول النهضة الحسينية، ومقارنتها بما توصلّ إليه الباحث الدكتور الصلّابي.
2 ـ ثمّ انتقل إلى مرحلة تبويب الشبهات المطروحة على وفق الحقب التاريخية الموصوفة سابقاً، وقررها بصورة ملائمة لمنهج دراسة التاريخ في الوقت الحاضر، ثمّ حللها طبقاً لأدلّتها، وبيّن السليم من السقيم، واستنتج منها.
3 ـ ثمّ نقد الشبهات المقررة، على مستويات عدة: نقداً مباشراً أو نقضياً أو مبنائياً، أو غيرها.
ولا شك في أنّ الدراسة قد حرصت على الأمانة العلمية، في طرح وجهات نظر السلفية وتقرير شبهاتهم، وهذه الأمانة في تقرير الشبهات اعتمدت أيضاً في كيفية النقل من المصادر كافة، سواء أكان النقل من كتب الإمامية أم من كتب أهل السنة، أم من الأطروحات والكتب المختلفة.
مصادر الدراسة
اعتمدت هذه الدراسة على القرآن الكريم ونهج البلاغة، وطوائف من المصادر، يمكن إجمالها، بما يلي:
التاريخ
1 ـ مقتل الحسين×، أبو مخنف، وفاة: (157ﻫ، 774م)، المنقول عنه.
2 ـ الطبقات، محمّد بن سعد البغدادي، وفاة: (230ﻫ، 845م).
3 ـ تاريخ ابن خياط، خليفة بن خياط، وفاة: (240ﻫ، 854م).
4 ـ الإمامة والسياسة، عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، وفاة: (276ﻫ، 889م).
5 ـ أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري، وفاة: (279ﻫ، 892م).
6 ـ الأخبار الطوال، أحمد بن داود الدينوري، وفاة: (282ﻫ، 895م).
7 ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر، علي بن الحسين المسعودي، وفاة: (284ﻫ، 897م).
8 ـ تاريخ اليعقوبي، أحمد بن إسحاق اليعقوبي، وفاة: (بعد 292 ﻫ).
9 ـ تاريخ الطبري، محمّد بن جرير الطبري، وفاة: (310ﻫ، 923م).
10ـ الفتوح، أحمد بن أعثم الكوفي، وفاة: (314ﻫ، 927م).
11ـ مقاتل الطالبيين، علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني، وفاة: (356ﻫ، 967م).
12ـ تاريخ بغداد، أحمد بن علي الخطيب البغدادي، وفاة: (463ﻫ، 1071م).
13ـ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، جار الله محمود بن عمر الزمخشري، وفاة: (538ﻫ، 1144م).
14ـ تاريخ دمشق، علي بن الحسن بن عساكر، وفاة: (571ﻫ، 1176م).
15ـ مثير الأحزان، محمّد بن جعفر ابن نما الحلي، وفاة: (645ﻫ، 1281م).
16ـ بغية الطلب في تاريخ حلب، عمر بن أحمد بن العديم، وفاة: (660ﻫ، 1262م).
17ـ الكامل في التاريخ، علي بن محمّد الشيباني ابن الأثير، وفاة: (630ﻫ، 1232م).
18ـ شرح نهج البلاغة، عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد، وفاة: (656ﻫ، 1258م).
19ـ اللهوف [الملهوف] على قتلى الطفوف، علي بن موسی بن طاووس، وفاة: (693ﻫ، 1294م).
20ـ تاريخ ابن الوردي، عمر بن مظفر، وفاة: (749ﻫ، 1348م).
21ـ البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، وفاة: (774ﻫ، 1373م).
22ـ تاريخ الخلفاء، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، وفاة: (911ﻫ، 1505م).
ثانياً: الدراسات التاريخية الحديثة
وهي عبارة عن أطاريح أو بحوث أو دراسات أو رسائل جامعية، تناولت بعض الأمور مورد البحث في هذه الدراسة، فمنها من تناول فترة معينة من التاريخ، ومنها من تناول أشخاصاً لعبوا دوراً فيه، منها: ما ذكر في الفقرة الخاصة بالدراسات السابقة، ومنها:
1 ـ إشكالية النهضة بين مالك بن نبي وسيد قطب، أرفيس علي.
2 ـ أنا الحسين بن علي، معروف عبد المجيد.
3 ـ تاريخ الدولة الأموية: ٦٦١ ـ ٧٥٠ م، د. محمّد سهيل طقوش.
4 ـ تاريخ الدولة الأموية، د. إيناس محمّد البهيجي.
5 ـ تاريخ موجز للفكر العربي، د. حسين مؤنس.
6 ـ جواهر التاريخ، الشيخ عليّ الكوراني العاملي.
7 ـ الحالة السلفية المعاصرة في مصر، أحمد زغلول شلاطة.
8 ـ الدولة الأموية، محمّد الخضري بك، وفاة: (1345ﻫ، 1927م).
9 ـ سب معاوية وولاته لأمير المؤمنين×، دراسة حديثية تاريخية، د. حاتم البخاتي.
10ـ السلف المتخيل: مقاربة تاريخية تحليلية في سلف المحنة، رائد السمهوري.
11ـ السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامي، محمّد سعيد البوطي.
12ـ الشيعة الإمامية بين النص والتاريخ، وجيه قانصو.
13ـ الصحابي بسر: دراسة تاريخية، د. نافع مصعب جاسم.
14ـ الصراع على السلفية، د. محمّد سليمان أبو رمان.
15ـ صلح الحسن×، راضي عبد الحسين آل ياسين الكاظمي، وفاة: (۱۳۷۲ﻫ، 1952م).
16ـ العالم الإسلامي في العصر الأموي: دراسة تحليلية، د. عبد الشافي محمّد عبد اللطيف.
17ـ فقه السلفية المعاصرة: دراسة في المفهوم، عارف حسين الأميري.
18ـ قراءة المدرسة السلفية المعاصرة لتاريخ الشيعة الإمامية، حسين البدري.
19ـ القول السديد في سيرة الحسين الشهيد، د. محمّد بن عبد الهادي الشيباني ومحمّد سالم الخضر.
20ـ مفردات حركة الإصلاح للنهضة الحسينية وتعزيزها في المنهج المدرسي، د. صباح حسن عبد الزبيدي.
21ـ المنهج السلفي: تاريخه مجالاته قواعده خصائصه، د. مفرح القوسي.
22ـ الوفادات على الخلفاء الأمويين: دراسة تاريخية، د. جاسم محمّد جاسم.
23ـ ولاية العهد في العصر الأموي: دراسة تاريخية، سمر محمّد السيد إبراهيم.
1 ـ صحيح البخاري.
2 ـ صحيح مسلم.
3 ـ علل الشرائع، محمّد بن علي القمي المشهور بالصدوق، وفاة: (381ﻫ، 992م).
4 ـ الكافي، محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، وفاة: (329ﻫ، 941م).
5 ـ مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني، وفاة: (241ﻫ، 855م).
1 ـ الإصابة في تمييز الصحابة.
2 ـ السيد أبو المعاطي النوري وآخران، موسوعة أقوال أحمد في رجال الحديث وعلله.
1 ـ ابن باز في الدلم قاضياً ومعلماً، د. عبد العزيز ناصر البراك.
2 ـ الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي، يوسف عبد الله القرضاوي.
3 ـ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، المحنة على إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل.
4 ـ عبد الله بن فوزان الفوزان، المحنة وأثرها في منهج الإمام أحمد النقدي.
1ـ الإرشاد، محمّد بن محمّد بن النعمان المشهور بالمفيد، وفاة: (413ﻫ، 1022م).
2ـ تخريج العقيدة الطحاوية للطحاوي، محمّد ناصر الدين الألباني، وفاة: (1420ﻫ، 1999م).
3 ـ شرح العقيدة الطحاوية، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي.
4 ـ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، أحمد بن محمّد بن حجر الهيتمي، وفاة: (974ﻫ، 1566م).
5ـ العقيدة الطحاوية، الطحاوي.
6ـ العواصم من القواصم، محمّد بن عبد الله بن العربي، وفاة: (543ﻫ، 1148م).
7ـ الملخّص في أصول الدين، علي بن الحسين الموسوي الشريف المرتضى، وفاة: (436ﻫ، 1044م).
8ـ منهاج السنة النبوية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، وفاة: (728ﻫ، 1328م).
1ـ الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة، جمال بن فريحان الحارثي.
2ـ إيضاح الفوائد، فخر المحققين محمّد بن الحسن فخر المحققين، وفاة: (771ﻫ، 1370م).
3ـ جامع المقاصد، علي بن الحسين الكركي، وفاة: (940ﻫ، 1533م).
4ـ جواهر الكلام، محمّد حسن النجفي الأصفهاني المشهور بصاحب الجواهر، وفاة: (1266ﻫ، 1849م).
5ـ ذكرى الشيعة، محمّد بن جمال الدين مكي العاملي المشهور بالشهيد الأوّل، وفاة: (786ﻫ، 1384م).
6ـ فتاوى اللجنة الدائمة، بالمملكة العربية السعودية، أحمد عبد الرزاق الدويش.
7ـ فتاوى نور على الدرب، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وفاة: (1420ﻫ، 1999م).
8ـ موطأ مالك.
9ـ نور على الدرب، محمّد بن صالح العثيمين، وفاة: (1421ﻫ، 2001م).
1 ـ تاج اللغة، الجوهري.
2 ـ التعريفات الفقهية، محمّد عميم الإحسان المجددي.
3 ـ التعريفات، الجرجاني.
4 ـ تهذيب اللغة، الأزهري.
5 ـ جمهرة اللغة، ابن دريد.
6 ـ العين، الفراهيدي.
7 ـ لسان العرب، ابن منظور.
8 ـ المحيط في اللغة، ابن عباد.
9 ـ المخصّص، ابن سيده.
10ـ المعجم الوسيط، الدكتور إبراهيم مصطفى وآخرين.
11ـ موسوعة الفلسفة والفلاسفة، عبد المنعم الحنفي.
12ـ موسوعة مصطلحات الفكر العربي والإسلامي، الدكتور جيرار جهامي.
كتب الصلاّبي
1 ـ الإيمان بالقدر.
2 ـ الدولة الأموية.
3 ـ عمر بن عبد العزيز: معالم التجديد والإصلاح الراشدي على منهاج النبوة.
4 ـ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: شخصيته وعصره.
5 ـ معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره.
هيكلية الدراسة
تتألف هذه الأطروحة من أربعة فصول وهي كالآتي:
الفصل الأوّل: اختص بالمباحث التمهيدية.
الفصل الثاني: الأسباب التي أدّت إلى النهضة الحسينية بنظر السلفية ومناقشتها.
الفصل الثالث: مناقشة شبهات الصلّابي حول بيعة يزيد.
الفصل الرابع: مناقشة شبهات الصلّابي في ميل الإمام الحسين× إلى الاستسلام.
ولا شك في أنّ الكمال لله تبارك وتعالى.