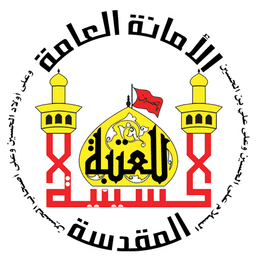إلى... متمِّم مسيرة الإصلاح وناشر
العدل الإمام المهدي
إلى... أمِّ السِّبطين الحسنين حبّاً وحنوّاً وعطاءً وتقديساً
إلى... سيّدتي ومولاتي الفاضلة النَّبيلة المقدَّسة أمِّ البنين
إلى... رائدة الفتح الحسيْنيّ وركبِ الإباء السيدة زينب
إلى... كريمة أهل البيت العلويَّة الطَّاهرة فاطمة المعصومة
إلى... روح برعم القرآن حبيب الزهراء ولدي إليهم جميعاً أهدي هذا الجهد القليل
شكر وعرفان
إلى... عمادة كلّية الآداب أتقدّم بالشكر والثناء، وأتوجّه بالشكر إلى أساتذتي في قسم اللُّغة العربية، وأخصّ منهم رئيس القسم الأستاذ المساعد الدكتور محمّد عبد كاظم، وأساتذتي، وزملائي في المرحلة التحضيرية، وأخصّ بالشكر الجزيل الدكتور حيدر عودة الدرّاجي؛ لما قدّمه لي من العون والمساعدة، وكذلك أقدّم وافر شكري لكل من الدكتور علي عبد الرسول، والأستاذ عماد طالب موسى، والأستاذ علي عباس، والأستاذ عمار حسن عبد الزهرة، والأخت سارة الرجب؛ لما أبدوه من نصح وتوجيه في مشوار الكتابة، ولا أنسى فضل كل من الشيخ زياد حسّون الساعدي والشيخ علي جعفر.
كما أتوجّه بجميل الثناء إلى العاملين في مكتبة قسم اللغة العربية ومكتبة الكلّية في كلّية الآداب، وكلّية التربية. وأخصّ بالشكر إدارة المكتبة الحيدرية وكادرها المحترم، وإدارة المكتبة الحسينية، والمكتبة العباسية، وبالأخص الأستاذ سجّاد المحمّدي، على ما أبدوه من مساعدة يعجز اللسان عن وصفها، وشكري وتقديري لكلّ الأهل والأقارب، وبالأخصّ والدي والأصدقاء، ومَن أعانني ـولو بفضل دعاءـ على إنجاز هذا العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقيّة وسعادته الأبديّة المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدّد خيارات الإنسان الصحيحة، وفي ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله على سائر المخلوقات، واحتجّ عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)[1]، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر، ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله، إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)[2]، وبهما تُسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمّة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله} بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[3]، فكانت الإجابة: (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)[4]، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاء الأئمّة^ ومبتغاهم من الله لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»[5].
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيّات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه سيرة الأنبياء والأئمّة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار؛ لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسّسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبيّ أو وصي، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أُنيطت بهم^، كما أخبر} بذلك في قوله: (ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)[6]، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقيّة سِيَر الأنبياء^، كما أنّ سيرة الأئمّة^ ليست كبقيّة سِيَر الأوصياء السابقين، كما أنّ التفاوت في سِيَر الأئمّة^ فيما بينهم ممّا لا شكّ فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقيّة الأئمّة^.
والإمام الحسين× تلك الشخصيّة القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة الذين دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الرباني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصيّة العظيمة التي ملأت أركان الوجود، تعلَّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفيّة والعمليّة، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمسّ الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قِبَل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم، وأفنوا أغلى أوقاتهم، وزهرة أعمارهم؛ لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفيّة التي تركها× للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفيّة في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: هي أكثر ممّا تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعدّدة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤوليّة المهتمّين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق؛ بادرت الأمانة العامّة للعتبة الحسينيّة المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكريّة والعلميّة حول شخصيّة الإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى وبالأساس بمسك هذا الملف التخصّصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسيّة، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة، التابعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميين ـ على شخصيّة الإمام الحسين×، ونهضته المباركة، وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطّة مبرمجة، وآليّة متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصّين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلميّة التخصّصيّة، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفِّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينيّة المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصيّة الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلميّة في المؤسّسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسَّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلميّة في المجال الحسيني، تمّ تحديد مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهمّيته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويّات المعتمد في المؤسّسة تمّ اختيار المشاريع العلميّة الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعيّة للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينيّة التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلميّة وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها، يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث الحسيني، وقد تمّ العمل على نحوين:
الأوّل: التحقيق في المقاتل الحسينيّة، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، وذلك تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينيّة التي لم تُطبع إلى الآن؛ وقد قمنا بجمع عدد كبير من المخطوطات القيّمة، التي لم يطبع كثير منها، ولم يصل إلى أيدي القرّاء إلى الآن.
الثاني: استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسّسة، لغرض طباعتها ونشرها بعد إخضاعها للتقويم العلمي من قبل اللجنة العلميّة في المؤسّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وتأييد صلاحيتها للنشر، تقوم المؤسّسة بطباعتها.
الثاني: مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصلّية متخصّصة في النهضة الحسينيّة، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينيّة وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانيّة، والاجتماعيّة والفقهيّة والأدبيّة في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلّات العلميّة الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلميّة الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينيّة
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبّع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونيّة، وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علميّ تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: الموسوعة العلميّة من كلمات الإمام الحسين×
وهي موسوعة علميّة تخصّصيّة مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون العمل فيها من خلال جمع كلمات الإمام الحسين× من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلميّة، والعمل على دراسة هذه الكلمات المباركة؛ لاستخراج نظريّات علميّة تمازج بين كلمات الإمام× والواقع العلمي. وقد تمّ العمل فيه على تأليف موسوعتين في آن واحد باللغتين العربيّة والفارسيّة.
الخامس: قسم دائرة المعارف الحسينيّة الألفبائيّة
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام، وبلدان، وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب الحروف الألفبائيّة، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة بلغةٍ عصـريّة وأُسلوبٍ حديث، وقد أُحصي آلاف المداخل، يقوم الكادر العلمي في هذا القسم بالكتابة عنها، أو وضعها بين يدي الكُتّاب والباحثين حسب تخصّصاتهم؛ ليقوموا بالكتابة عنها وإدراجها في الموسوعة بعد تقييمها وإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل اللجنة العلميّة.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعيّة
يتمّ العمل في هذا القسم على مستويين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعيّة التي كُتبتْ حول النهضة الحسينيّة، ومتابعتها من قبل لجنة علميّة متخصّصة؛ لرفع النواقص العلميّة وإدخال التعديلات أو الإضافات المناسبة، وتهيئتها للطباعة والنشر. الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة ـ يضمّ العنوان وخطّة بحث تفصيليّة ـ من قبل اللجنة العلميّة في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعيّة، وتوضع في متناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
الهدف من إنشاء هذا القسم إثراء الساحة العلميّة بالتراث الحسيني عبر ترجمة ما كتب منه بلغات أخرى إلى اللغة العربيّة، ونقل ما كتب باللغة العربيّة إلى اللغات الأخرى، ويكون ذلك من خلال إقرار صلاحيّة النتاجات للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ذلك إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيّات، والمواقع الإلكترونيّة، والكتب، والمجلّات والنشريّات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضيّة الحسينيّة بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقيّة المؤسّسات والمراكز العلميّة في شتّى المجالات. ويقوم هذا القسم بإصدار مجلّة شهريّة أخباريّة تسلّط الضوء على أبرز النشاطات والأحداث الحسينيّة محليّاً وعالميّاً في كلِّ شهر، بعنوان: مجلّة الراصد الحسيني.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات والملتقيات العلميّة
يعمل هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكريّة متخصّصة في النهضة الحسينيّة، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، وتتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلميّة في المؤسّسة، وكذا سائر الباحثين والمحقّقين، وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينيّة وفق الأدوات الاستنباطيّة المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة
يضمّ هذا القسم مكتبة حسينيّة تخصّصيّة تعمل على رفد القرّاء والباحثين في المجال الحسيني على مستويين:
أ ـ المكتبة الحسينيّة التخصّصيّة، والتي تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسَّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصُّصها.
ب ـ المجال الإلكتروني، إذ قامت المؤسّسة بإعداد مكتبة إلكترونيّة حسينيّة يصل العدد فيها إلى أكثر من ثمانية آلاف عنوان بين كتب ومجلّات وبحوث.
الحادي عشر: قسم الإعلام الحسيني
يتوزّع العمل في هذا القسم على عدّة جهات:
الأُولى: إطلاع العلماء والباحثين والقرّاء الكرام على نتاجات المؤسّسة وإصداراتها، ونشر أخبار نشاطات المؤسّسة وفعّاليّاتها بمختلف القنوات الإعلاميّة ووسائل التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع.
الثانية: إنشاء القنوات الإعلاميّة، والصفحات والمجموعات الالكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي كافّة.
الثالثة: العمل على إنتاج مقاطع مرئيّة في الموضوعات الحسينيّة المختلفة، مختصرة ومطوّلة، وبصورة حلقات مفردة ومتسلسلة، فرديّة وحواريّة.
الرابعة: إعداد وطباعة نصوص حسينيّة وملصقات إعلانيّة، ومنشورات حسينيّة علميّة وثقافيّة.
الخامسة: التواصل مع أكبر عدد ممكن من القنوات الإعلاميّة والصفحات والمجموعات الالكترونيّة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتزويدها بأنواع المعلومات من مقاطع مرئيّة ومنشورات وملصقات في الموضوعات الحسينيّة المختلفة، الشاملة للتاريخ، والسيرة، والفقه، والأخلاق، ورد الشبهات، والمفاهيم، والشخصيّات.
الثاني عشر:قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصِّص، يقوم بنشر إصدارات وفعاليّات مؤسَّسة وارث الأنبياء، وعرض كتبها ومجلّاتها، والترويج لنتاجات أقسامها ونشاطاتها، وعرض الندوات والمؤتمرات والملتقيات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسّسة، ومجمل فعّاليّاتها العلميّة والإعلاميّة. بالإضافة إلى ترويج المعلومة الحسينيّة والثقافة العاشورائيّة عبر نشر المقالات المختلفة، وإنشاء المسابقات الحسينيّة، والإجابة عن التساؤلات والشبهات.
الثالث عشر: قسم إقامة الدورات وإعداد المناهج
يتكفّل هذا القسم بإعداد الدورات الحسينيّة في المباحث العقديّة والتاريخيّة والأخلاقيّة، ولمختلف الشرائح والمستويات العلميّة، وكذلك إقامة دورات تعليميّة ومنهجيّة في الخطابة الحسينيّة، كما يضطلع هذا القسم بمهمّة كبيرة، وهي إعداد مناهج حسينيّة تعليميّة وتثقيفيّة لمختلف الفئات وعلى عدّة مستويات:
أوّلاً: إعداد مناهج تعليميّة للدراسات الجامعيّة الأوليّة والدراسات العليا.
الثاني: إعداد مناهج تعليميّة في الخطابة الحسينيّة.
الثالث: إعداد مناهج تعليميّة عامّة لمختلف شرائح المجتمع.
الرابع: إعداد مناهج تثقيفيّة عامّة.
الرابع عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصّص وبأقلام علميّة نسويّة في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، ورفد أقسام المؤسّسة بالنتاجات النسويّة، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبيّة، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الخامس عشر: القسم الفنّي
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينيّة التي تصدر عن المؤسّسة، من خلال برامج إلكترونيّة متطوِّرة، يُشرف عليها كادر فنيّ متخصِّص، يعمل على تصميم أغلفة الكتب والإصدارات، والملصقات الإعلانيّة، والمطويّات العلميّة والثقافيّة، وعمل واجهات الصفحات الإلكترونيّة، وبرمجة الإعلانات المرئيّة والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها أقسام المؤسّسة كافّة.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.
هذه الرسالة: الاستلزام الحواري في خطاب المسيرة الحسينية
إنّ الدراسات اللسانية الحديثة والقديمة للنصِّ بوجه عام وللخطاب والحوار بوجه خاص ـ على ما فيها من جدل وعراك محتدم ـ شكّلت اهتماماً كبيراً لدى الباحثين والمحقّقين في هذا المجال؛ وذلك لأهميّة تلك النصوص والخطابات شكلاً ومضموناً لما تحتويه من مضامين راقية ومقاصد سامية، هذا من جانب، ومن جانب آخر تُوقِف المتتبّع على فنّ الكلام وأسلوب البيان وإبراز المراد والمقاصد فيها، ممّا يُساهم في بلورة الأفكار وفهم الآخر بشكل دقيق وممتع، ولم تكن النهضة الحسينية المباركة بمعزل عن تلك الدراسات واهتمام الباحثين فيها؛ لما تمتلكه من عناصر الاستقامة والخطاب الهادف، ومن وفرة للخطابات والحوارات الفريدة من نوعها على طوال مسيرة وحركة النهضة إلى نحو أهدافها المرسومة، وممّا يؤكّد أهميّة هذه الدراسات اللغوية واللسانية للخطاب الحسيني؛ كون أهل هذا البيت هم أصل الفصاحة والبلاغة ومعدن الحكمة والنباهة، وكلامهم^ يتضمّن أسمى القيم التعبيرية المستلزمة من ظواهر خطبهم وحواراتهم، فلا يمكن لباحث أو متابع غض النظر عن تلك النصوص والحوارات الصادرة عنهم^.
ومن هذا المنطلق جاءت هذه الرسالة (الاستلزام الحواري في خطاب المسيرة الحسينية)؛ لتضع الخطاب الحسيني تحت آليات المنهج التداولي، الذي يدرس الخطاب دراسة خاصّة؛ لكي يتوصّل من خلالها إلى ما ورائية الخطاب أو ما ورائية الاستعمال؛ بغيةً للكشف عن عمق الغاية وجمالية الصورة البلاغية، والوقوف على المعاني المنشودة والإرادة المقصودة من وراء تلك الخطابات المباركة أو الاقتراب منها، وهو الأمر الذي يكشف للقارئ عظم مظلومية هذه النهضة وأصحابها.
وفي الختام نسأل الله تعالى للمؤلِّف دوام السَّداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يُبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلميّة في
مؤسّسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصّصيّة في النهضة الحسينيّة
مقدّمة قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، وأشرف بريّته محمّد’ وآله الطيّبين الطاهرين.
لا يخفى أنّ الدراسات اللّسانية تُعدّ من أهمّ الدراسات التي امتدّت أغصانها إلى أغلب فروع العلوم الإنسانية، فهي وإن افتقدت إلى التبويب ـ التي هي عليه الآن ـ في الدراسات القديمة إلّا أنّها قديمة قدم الخطاب الانساني. والنهضة الحسينية قد زخرت بفنون ذلك الخطاب شعراً ونثراً، حتى جذبت إليها أصناف المبدعين من الدارسين شرقاً وغرباً.
من بين تلك الفنون فنّ الإستلزام الحواري الذي ينصبّ على دراسة ما ورائية الخطاب واستعماله وفقاً لآليات المنهج التداولي، وهذا ما اختصّت بدراسته الرسالة التي بين أيدينا، حيث سلّطت الضوء على الاستلزام الحواري في خطاب المسيرة الحسينية؛ لتلمس ما ورائية الخطاب الحسيني، كونه خطاباً متميّزاً كمّاً وكيفاً، دقّة وموضوعاً، طرحاً وملائمةً.
تميّزت هذه الرسالة بهيكلتها المتسلسلة منطقيا شكلاً ومضموناً، بدءاً من التمهيد إلى فصولها الأربعة، وصولاً إلى خاتمة متضمّنة لنتائج البحث، حيث تتبّع الباحث من خلال تلك الفصول حوارات وخطابات المسيرة الحسينية، مراعياً التراتب الزمني لأحداث وواقعة النهضة الحسينية، محاولاً من خلال البنية التركيبية لتلك الخطابات الملائمة بينها وبين الأحداث، وملامسة المرادات الجدية لفاعلي الخطاب.
مع أنّ الباحث استخدم المنهج التوصيفي والتحليلي الذي يُنتهَج عادةً في مثل هذه الدراسات، إلّا أنّ الجنبة التحليلية في هذه الدراسة تفترق عن غيرها؛ لأنّها تعتمد المنهج التحليلي التداولي، وهو منهج خاصّ في الدراسات اللّسانية يلامس مقاصد وغايات الخطاب سياقياً ومقامياً.
كل تلك الميزات والخصائص كانت كافية لجلب أنظار أعضاء قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، وعدّها من الرسائل المرشحّة للطباعة؛ فجاء العمل عليها من طرف القسم تقييماً وتقويماً ومتابعة التصحيحات والتعديلات مع صاحبها، حيث قُوّمت خطابات المسيرة الحسينية ورُوجعت في مصادرها الموثوقة، وعُدّلت بعض الصياغات لغوياً وعلمياً، وغُيّر ترتيب بعض المباحث بما يتناسب ومحتوى الفصول المندرجة تحتها، كما تمّ العمل على التدقيق في توثيق المصادر؛ لتأتي في الأخير مرحلة طباعتها وتقديمها في حلّتها الحالية بين أيدي القرّاء والباحثين.
قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
في مؤسسة وارث الأنبياء
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمّد وآله الطاهرين...
تنطوي المنظومة اللسانية في المجال الاستعمالي والإجرائي القصدي على مجموعة من المعايير، والتقنيات الأسلوبية التي أصبحت شرعة لكلّ وارد يتوخّى امتطاء صهوة البحث اللساني. إذ يتجلى ذلك اليومَ في البعد التداولي اللساني؛ ذي الميادين الإجرائية لكلّ المقاصد التخاطبية، فالتداولية فنّ يسعى إلى استنطاق اللغة المستعملة في مجالها الاستعمالي، ولعلّ هذا المعنى ما تبيّن بوضوح في الاستلزام الحواري، وكذلك الفعل الكلامي، لاسيما غير المباشر الذي يحتكم في كلِّ أبعاده إلى مقاصد الخطابات التحاورية، ولا يعبأ بالمنطوق النصّي المتشكّل من تعانق الألفاظ بعضها ببعض، بل يتوخّى ما تخفيه تلكم الألفاظ من مغازٍِِ ومعانٍ لا يُفصح عنها اللفظ وحده، بل يفصح عنها قصد القصد.
إنّ الاستلزام الحواري هو فنّ دراسة الخطاب بعد تحليله للتوصّل إلى ما ورائية الخطاب، أو ما ورائية الاستعمال، وهذا ما حاول البحث الوقوف على تجلّياته بأبهى صورة في كلام أئمة أهل البيت^؛ ذلك لعلوّ كلامهم على كلام من سواهم، ولما تضمّنه من القيم التعبيرية القصدية المستلزمة من ظواهر خطاباتهم. من هنا جاء عنوان هذه الرسالة وهو (الاستلزام الحواري في خطاب المسيرة الحسينية) ليُجليّ للقارئ مقاصد تلكم الخطابات الشريفة، وما فيها من اللطائف الخطابية اللّغوية كماً وكيفاً، تلك اللطائف التي من شأنها التأثير أسلوبياً في الآخر، مهما كان نوع ذلك الآخر ما دام وازع التأثير متوفّراً في المنتج الخطابي؛ لأنّه منتجٌ متمكّن من ناحية اللغة. وهذا هو ما حدا بالباحث للولوج في نفائس تلك الخطابات الحسينية المقدّسة على الرغم من العقبات الكبيرة التي حصلت في طريق إكمال هذه الرسالة، كالاختلاف الروائي بين مؤرّخي تلك الخطابات، التي سرى إلى معانيها ممّا صعّب عملية المزاوجة بين الخطب المتباينة جزئياً، فضلاً عن كونها خطباً قيلت أمام مستمعين.ولعلّ هذا الأمر قد يأتي على تغييب بعض مرادات المتكلّمين ومقاصدهم عند دراستنا لخطابهم المكتوب، أما وأنّها قد قيلت أمام الملأ، فالذي يغيب حينها هو الطبيعة الصوتية المنسجمة مع الخطاب.
حاول الباحث الاعتماد على كمّية كبيرة من المصادر التاريخية المعتبرة كأنساب الأشراف للبلاذري (279هـ)، وتاريخ اليعقوبي (292هـ)، وتاريخ الطبري (ت310هـ)، ومروج الذهب للمسعودي (ت346هـ)، والإرشاد للشيخ المفيد (ت413هـ)، والاحتجاج للطبرسي (ت520هـ)، ومقتل الحسين للخوارزمي (ت568هـ)، والصحيح من مقتل سيّد الشهداء لمحمد الري شهري.
فضلاً عن الدراسات اللّغوية والأدبية التي تناولت الخطابات العلوية والحسينية تحليلاً، والتي كانت محطّ اهتمام الدارسين، وقد وقع اختيارنا على مجموعة منها كرسالة (خطب سيّدات البيت العلوي)، و(التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية)، و(نثر الإمام الحسين× دراسة بلاغية)، و(أدب الإمام الحسين× قضاياه الفنية والمعنوية)، ودراسة (كلام الإمام الحسين× مقاربة تداولية)، و(أدعية الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين× مقاربة تداولية)، و(الاستلزام الحواري في خطب نهج البلاغة الطوال)، وأطروحتي الدكتوراه (الحجاج في كلام الإمام الحسين×)، و(نثر الإمام الحسين× دراسة تحليلية في جماليات بنية النص)... الخ.
أما هذه الرسالة الموسومة بالاستلزام الحواري في خطاب المسيرة الحسينية فقد اهتمّت بدراسة ذلك الخطاب وفقا لآليات المنهج التداولي، إذ حاول الباحث إحصاء كل تلك الحوارات والخطابات عبر مختلف محطّات المسيرة، ابتداءً من انطلاقها وخروج الركب الحسيني، مروراً بمحطّات الرحلة والسبي، وانتهاءً برجوع السبايا إلى المدينة. كما حاول التوفيق بين الخطابات ومجريات الأحداث التي تفسّرها بنية التراكيب من الخارج، سعياً منه في الوصول إلى مقاصدهم أو الاقتراب منها، الأمر الذي يكشف للقارئ عظم مظلوميّتهم^، وبيان أهداف خطابهم وغاياته ومسوّغاته. وقد استعان الباحث بمنهج جديد في ضوء الدراسات اللسانية، وهو منهج التحليل التداولي، الذي استوعب خطاب المسيرة ـ في ضوء الاستلزام الحواري وهو أحد أدوات المنهج التداولي ـ من زوايا مختلفة سياقياً ومقامياً، محاولاً تلمّس مقاصده وغاياته بإجراء تطبيقي مفعم بالشواهد والأمثلة. وبعد تحديد المنهج والتصنيف جاء البحث بخطّة تتناسب وطبيعة المنهج المعتمد ومتن الرسالة، مشتملاً على تمهيد وأربعة فصول، تسبقها مقدّمة، وتعقبها خاتمة متضمّنة لنتائج البحث.
تضمّن التمهيد الاستلزام الحواري (النشأة والمفهوم) لغةً واصطلاحاً، وأقسام الاستلزام الحواري، وتطبيقات على القسم اللّغوي من الاستلزام الحواري لقلّتها أولاً، ولاهتمام البحث في القسم الثاني بموضوع الرسالة الذي شكّل فصولها وعليه أكثر التطبيقات ثانيا.
أما الفصل الأوّل: الاستلزام الحواري في ضوء قاعدة الكم، فقد تضمّن ـ بعد التعريف بقاعدة الكم ـ مبحثين: الأوّل احترام قاعدة الكم من خلال توخّي الدقّة الموضوعية في الحوار، والالتزام بوحدة الموضوع وكمّيته. والثاني خرق قاعد الكم، في ضوء تقديم معلومات أكثر مما يتطلّبه المقام، وعلى وفق الخرق المختزل الذي يحصل بإعطاء أخبار مكثّفة أقل مما يتطلّبه المقام.
وقد نهض الفصل الثاني بدراسة الاستلزام الحواري عبر قاعدة الكيف بمبحثين هما: الأوّل احترام قاعدة الكيف في ضوء تحرّي صدق المتكلّم واعتقاده في كل ما ينقل ويقول، ولا تقل ما تعتقد بكذبه أو ليس لديك دليل عليه. والثاني خرق قاعدة الكيف، والاستخفاف في قاعدة الكيف، وهو ما عليه أكثر خطب المسيرة الحسينية التي استندت إلى الوسائل البيانية من التشبيه، والاستعارة، والكناية.
وقد تناول الفصل الثالث الاستلزام الحواري في ضوء قاعدة الملاءمة، وبعد التعريف بها وبيان أهمّيتها، تطرقنا إلى مبحثين: الأوّل احترام القاعدة من خلال وضوح الألفاظ. والثاني خرق القاعدة من خلال خرق مقتضيات السياق مقامياً وحوارياً.
أما الفصل الرابع فقد تمثّل بعنوان الاستلزام الحواري عبر قاعدة الطريقة من خلال مبحثين: أولهما احترام قاعدة الطريقة، من خلال توخّي الوضوح والترتيب في متوالية الملفوظات، وثانيهما خرق قاعدة الطريقة من خلال الاستخفاف، وهذا الاستخفاف يأتي على مستويات عدّة بحسب المقولات الفرعية لهذه القاعدة في ضوء الالتباس والغموض، والإطناب والتطويل، وخرق الترتيب في سياق الملفوظات.
ثم خُتمت هذه الفصول بخاتمة تضمّنت أهم النتائج التي توصّل إليها الباحث.
وختاماً يطيب لي أن أتقدّم بالشكر والثناء والامتنان لله تعالى الذي يسّر لي أمري، وسهّل لي الصعب من بحثي وظرفي الخاص بعد التوسّل عنده بسيّد الشهداء×.
وأتقدّم بالشكر الجزيل لأستاذي المشرف الدكتور عامر عبد محسن السعد على ما أبداه من رعاية علمية خالصة، وتوجيهات سديدة ذلّلت لي الكثير من الصعوبات، فلطالما كان لي أستاذاً وأباً روحياً يُكرمني بعلمه ونصحه كلّما رآني محتاجاً إليهما، ولطالما كنت كذلك، فإن كان في البحث فضيلة فللّه المنّة أولاً، وللإمام الحسين^ ثانيا، وإن كان فيه نقص أوخلل فمنّي.
ومع كل ما توصلت إليه في هذا البحث؛ إلا أنه يبقى إنجازاً لبني البشر الذين يخطئون ويصيبون، فلا أدّعي الكمال فيه، بل أدّعي أنني لم أدّخر وسعاً للوصول إلى غاياته، وإن كان ثمّة خلل أو تقصير يتعين أن يجبر؛ فإنّه يقع على عاتق من يأتي بعدي لإكمال هذا المشوار، وأسأل الله أن ينفعني بهذا العمل المتواضع يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن ينفع بي غيري. ربي اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم، إنّك أنت الأعزّ الأجلّ الأكرم وصلى الله على محمّد وآل محمّد الطيبين الطاهرين.
الباحث
الاستلزام الحواري النشأة والمفهوم
هناك كثير من المحاولات التي قام بها العلماء في شتّى مجالات الفكر والمعرفة، التي راحت تتقصّى أنجع الطرق وتستقرؤها، وتقدّم أهم النظريات اللسانية لدراسة تلك الرموز اللّغوية والاجتماعية العرفية، بوصفها أداة للتواصل بين أفراد المجتمع وفهم مقاصدهم، كما عبر عن ذلك ابن جنّي(ت392هـ) بقوله: «أصوات يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم»[7].
فالهدف من وراء هذا البحث، وأغلب البحوث التي تناولت الدرس اللساني ـ بعدما تعدّدت النظريات، واختلفت المذاهب والرؤى ـ هو إدراك حقيقة الخطاب الإنساني التواصلي وفهمه بالدرجة الأساس؛ أي: فهم حقيقة مقاصد المتكلّمين وأفكارهم، كما يقول الجاحظ(ت255هـ): «المعاني مطروحة في الطريق»[8]، «ثمّ اعلم حفظك الله أنّ حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ؛ لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية، وممتدّة إلى غير نهاية»[9].
ومن هنا انبثقت التداولية اللسانية التي عنيت بدراسة اللغة داخل السياق، وعنيت بالمرسل والمتلقّي والنصّ، وجميع الظروف المحيطة بهم، وليس بالألفاظ الموضوعة وغير المستعملة، كون اللغة التي تهتمّ بها النظريات التداولية ميدانها اللغة المستعملة الحيّة.
والحقيقة أنّ جهود العلماء الأوائل وتراثهم المعرفيّ، لاسيما اللّغوي منه، حافل بالمسائل اللّغوية، فنجدُ أنّ السكّاكي(ت626هـ)، وعبد القاهر الجرجاني (ت474هـ)، والسيد الشريف الجرجاني(ت816هـ) وغيرهم من المناطقة والأصوليين قد أولوا هذه المعاني ـ التي اهتمت بها التداوليةُ اللسانيةُ ـ الكثيرَ مِنْ الاهتمام تنظيراً وتطبيقاً، ابتداءً من دراستهم طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعنى، وتقسيم تلك العلاقة إلى حقيقية ومجازية [10].
إنّ وظيفة اللغة اتّسعت مع ظهور المنهج التداولي، فلم تقتصر على التبليغ والتوصيف، بل أصبحت أداة للتأثير في العالم، وإذا ما حاولنا البحث عن جذور التداولية الأولى فسنجدها مغروسة في الفلسفة التحليلة، وهو الاتجاه الرئيس في فلسفة اللغة أو التيار الغالب في الفلسفة المعاصرة؛ الذي ركّز على موضوع اللغة. وقد تأثّر بهذا المنهج التحليلي الذي جاء به (فريجه) عدد من الفلاسفة منهم (هوسرل، وكارناب، وفينغشتاين، وأوستن، وسيرل)، والمسلمة العامة المشتركة بين هؤلاء الفلاسفة هي أن فهم الإنسان لذاته ولعالمه يرتكز في المقام الأوّل على اللغة؛ فهي التي تعبّر له عن هذا الفهم. وقد اتسم هذا الاتجاه بجملة من السمات أهمّها:
1ـ ضرورة التخلّي عن أسلوب البحث الفلسفي القديم، ولا سيما جانبه الميتافيزيقي.
2ـ تغيير بوصلة الاهتمام الفلسفي من موضوع(نظرية المعرفة) إلى (التحليل اللّغوي)
3ـ تجديد بعض المباحث اللّغوية وتعميقها، لاسيما مبحث الدلالة والظواهر اللّغوية المتفرّعة عنه[11].
وقد انقسم الاتجاه الفلسفي التحليلي إلى ثلاثة تيارات فرعية ضمن مدرسة أكسفورد، أهمّها تيار اللغة العادية بزعامة فينغشتاين، وتيار اللغة المنطقية الذي يدرس اللغة الشكلّية أو الصورية بزعامة كارناب وآير، وتيار أفعال اللغة بزعامة أوستن وسيرل[12]. ولم يكن المنهج الوظيفي محطّ اهتمام هذه التيارات كلّها، حيث جانبه التياران الظاهراتي والمنطقي الصوري بسبب اهتمام الأخير باللغات الصورية المصطنعة، واتخاذها بديلاً عن اللغات الطبيعية، أما الظاهراتي فيرجع سبب مجانبته للمنهج الوظيفي إلى انغماسه في البحث ضمن أطر فكرية أعمق من الكينونة اللّغوية. وعليه لم يبق ضمن اهتمامات التداولية سوى تيار فلسفة اللغة العاديّة[13]، الذي ولد من رحمه تيار الأفعال اللّغوية الذي ركّز فيه أوستن على صفة الإنجازية في اللغة من خلال نظريته الشهيرة (الأفعال الكلامية) 1950 في جامعة هارفارد[14]، التي مضمونها أننا حين ننشئ أقوالا من خلال التعبيرات الإنشائية ونحوها مما يقترن فيه القول بعمل ما يصح أن نعدّه منجزاً حال انتهاء المتكلّم من فعل التلفّظ كبعتك، وزوّجتك، وواعدتك، ورجوتك، فإننا في الحقيقة ننجز أفعالاً بعد فعل القول. فالمنهج التداولي منهج تحليلي يتجاوز الوصف التركيبي للجملة ومقدار نحويّتها، الذي هو مدار علم التركيب أو علاقة المعجم (اللفظ) بالقضية الخارجية(المعنى) وهو مدار علم الدلالة، وهو بهذا يهتمّ بدراسة أثر المعارف غير اللّغوية في تأويل الأقوال وفهم مقاصدها وإنجازيتها، فضلاً عن اللسانيات اللّغوية كالبلاغة والأسلوبية والنحو والدلالة، فالبلاغة العربية إلى حد ما هي البراغماتية، والسياق هو المقام، والبلاغة ـ على حدّ تعبير ليتش ـ تداولية في صميمها[15].
ولما كان الاستلزام الحواري هو أحد آليات المنهج التداولي، صار لزاماً الوقوف على حقيقة هذا المعطى التداولي نشأةً وأصولاً. حيث تعددت تسمياته بين القدماء والمحدثين، فمثلاً يندرج الاستلزام عند القدماء تحت مسمّى المعنى المجازي ـ كما هي الحال ـ عند السكّاكي في مفتاح العلوم، أو الاقتضاء عند عبد القاهر الجرجاني، فاللغة كلّها اقتضاء بدلالة قوله: «وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك لأنّك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتّبها على حسب ترتّب المعاني في النفس. فهو إذن[16] نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض، وليس هو "النظم" الذي معناه ضمّ الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق...، ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل»[17]، فإعمال العقل في الاقتضاء هو المفضي إلى حقيقة القصد لا السياق وحده.
وقبل الدخول في تفاصيل النشأة والتطوّر لا بدّ من التعرّف على مفهوم المصطلح لغةً واصطلاحاً من خلال معرفة جذره اللّغوي، خاصّة وهو مركّب من مصطلحين، هما الاستلزام والحوار.
ثانياً: مفهوم الاستلزام الحواري
1ـ المدلول اللّغوي والاصطلاحي للاستلزام الحواري
يقتضي البحث في المعنى الذي ينطوي عليه مفهوم الاستلزام عند العرب على المستوى الأصولي واللساني التداولي، الوقوف على المقاصد التي يدلّ عليها الاستلزام عند القدماء والمحدثين بغية إيجاد الرؤية الواضحة لمدلول النظرية عند كل من الأصوليين، والتداوليين ـ إن كان هناك ثمّة فرق بين المعنيين ـ، وهو أمر يعطي النظرية الفهم الدقيق بعدما يتم التعرّف على منهج الفريقين في التعاطي مع مفهوم الاستلزام قبل البدء بالخوض في مادة البحث.
والمتتبّع لمفهوم الاستلزام عند علماء اللغة
المتقدّمين ـ تحديداً عند أرباب المعاجم ـ
سوف لا يجد عندهم، إلّا ما يبحثونه ضمن
دلالة لغوية واحدة تتصل بالجذر اللّغوي للمادة، فالخليل(ت175هـ) يرى أنّ
"اللزوم": معروف والفعل لزم والفاعل لازم، والمفعول: ملزم، ولازم،
ولزاماً[18]، وأكّد ابن منظور(ت711هـ) المعنى
نفسه في لسانه بقوله: «لَزِمَ:
اللزوم: معروف، والفعل لزم يلزمُ، والفاعل لازم، والمفعول ملزوم. لزم الشي يلزمه
لزماً ولزوماً ولازمَهُ مُلازمةً ولزاماً والتزمه وألزمه إيّاه فالتزمه، ورجل لزمةٌ:
يلزم الشيء فلا يفارقه. واللزام: الفيصل حداً»[19].
مع أنّ كلاً من اللزوم والإلزام يرجعان إلى مادة واحدة وهي لزم إلّا أنّ أبا هلال العسكري(ت395هـ) قد فرّق بينهما بقوله: «إنّ اللزوم لا يكون إلّا في الحق، يقال: لزم الحق ولا يقال لزم الباطل، والإلزام يكون في الحق والباطل، يقال: ألزمه الحق وألزمه الباطل، على ما ذكرنا»[20].
أما مفردة (حور) فقد رأى الفراهيدي أنّ: الحور: الرجوع إلى الشيء وعنه. والغُصّة إذا انحدرت يقال: حارت تحور، وأحار صاحبها، وكل شيء تغيّر من حال إلى حال، فقد حار يحور حوراً. ويرى الجوهري(393هـ)، وابن السكيت (ت244هـ) رأي الخليل: يقال حار يحور حوراً إذا رجع[21]. والتحاوُر: التجاوب، والمحاورة المجاوبة[22].
وأما اصطلاحاً: فالاستلزام الحواري يدلّ على أنّ جميع ما يتلفّظ به المرء من عبارات أو تراكيب تدلّ على معانٍ صريحة وأخرى مستلزمة أو ضمنية، تتعيّن معانيها داخل السياق الذي وردت فيه، فنظرية الاقتضاء التي تطوّرت على يد الفيلسوف البريطاني هربرت بول غرايس(1988م)، قد اتخذت أسلوباً موفّقاً في طريقة الاستعمال؛ لأنّ «الاقتضاء التخاطبي لم يكن نظرية لغوية فحسب، وانّما كان أداة مثمرة لحل كثير من المشكلات الفلسفية والمنطقية أيضاً»[23].
إنّ نظرية الاستلزام الحواري حديثة المعالجة يعود البحث فيها إلى محاضرات بول غرايس التي ألقاها سنة1967 تحت عنوان (المنطق والتخاطب) ومحاضرات سنة 1970 (الافتراض المسبق والاقتضاء التخاطبي)[24].
وقد سمّاه غرايس مصطلح الاقتضاء Implicature، والفعل Implicate، واشتقه من الفعل Imply، بمعنى يستلزم أو يتضمّن، وقد اشتق من الفعل اللاتيني Plicare، بالمعنى نفسه[25]، وهنا ينبغي التنويه على أنّ استعمال مصطلح الاقتضاء الأصولي أو الاستلزام التخاطبي الغرايسي يؤدّيان المعنى نفسه كما يراه الدكتور عادل فاخوري، خلافاً للدكتور طه عبد الرحمن الذي يرى أنّ الاستلزام التخاطبي يناسب مصطلح (المفهوم) الأصولي، في حين أنّ المفهوم الأصولي هو بعض الاستلزام الحواري، أو قل: إنّ المفهوم الأصولي هو الاستلزام الحواري العام نفسه؛ لأنّه لا ينتج من خرق القواعد الغرايسية، بل هو المدلول الالتزامي من السياق الاستعمالي في حقيقة الأمر كما في قوله: (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) فقد ذهب الأصوليون إلى حرمة ضرب الوالدين من الآية الشريفة؛ لأنّ النهي عن التأفّف عند الوالدين يستلزم حرمة ضربهما بالأوّلوية القطعية، فحرمة الشتم والضرب أولى من حرمة التأفّف، وهذا المستفاد من مفهوم الموافقة ـ كما يحلو لهم تسميته ـ، يضاف إلى ذلك أنّ الاقتضاء الأصولي هو ما يُبتنى على تقدير أمر خارج عن السياق اللّغوي، قد يكون عقلياً كما في قوله تعالى: (ﮚ ﮛ) أو شرعياً أو عرفياً[26]مع أنّ القرية ـ كما يرى الأصوليونـلا يمكن أن تكون مسؤولة؛ ولذا ذهبوا إلى تقدير أمر خارج عن السياق وهو مقتضى عقلاً (أهل القرية)، وهذا الاقتضاء الأصولي غير الاستلزام الحواري؛ لأنّ الاستلزام الحواري لا يعتمد التقديرات العقلية الخارجة عن دلالة السياق اللّغوي، بل هو مدلول ينتجه السياق بعد فهم مراد المنتج بشكل دقيق، فهو قراءة أخرى لمنطوق النص أو هو الفهم المتوخّى من المحتوى القضوي. كما أنّ عبد الله خليفة يرى: «أنّ التلويحات تختفي أو تعلّق في حالة خطاب المواجهة والتنافس حيث يحلّ العداء محلّ التعاون»[27]، وهذا الكلام لا يمكن القبول به؛ لأنّ مبدأ التعاون الغرايسي يفترض تعاوناً في المعطى اللّغوي لا العاطفي حتى نفترض مثل هذا النزوع التلويحي الذي يراه الدكتور خليفة، ولذا يمكن القول إنّ مبدأ التعاون يحصل بين المتخاطبين حتى عند غياب الانسجام العاطفي بينهما، أو حين كون الاحتدام التخاطبي مستعراً ما دام الإجراء اللّغوي قد هيمن على محورية التفاهم اللّغوي الذي يقتضي إفهام المخاطب ـأياً كان ذلك المخاطبـما دام يفهم مراد المنجز، وهذا هو مبدأ التعاون التداولي اللساني. ولذا استطاع روّاد النهضة الحسينية أن يوصلوا مقاصدهم ومراداتهم إلى متلقّين أقدموا على قتلهم والتمثيل بهم، ومع ذلك أوصلوا لهم ما أرادوا عبر الهيمنة اللّغوية، والتمكّن من ناصية الخطاب الإبلاغي؛ لأنّ الظروف التي قيلت فيها الخطابات كانت عاملاً مساعداً وبيئة مناسبة للفهم المقصود.
إنّ المعنى الاصطلاحي لمفهوم الاستلزام التخاطبي عند غرايس هو «عمل المعنى أو لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر، أو قل: إنّه شيء يعنيه المتكلّم ويوحي به ويقترحه ولا يكون جزءاً مما تعنيه الكلمة بصورة حرفية»[28].
أو بعبارة أُخرى: هو أن تقود سير التحاور ـ في اللغات الطبيعية ـ مجموعة من الافتراضات والتقديرات (Assumptins) الكامنة في كفاية المتحاورين والناتجة عن اعتبارات عقلية (Basic ratinal) مهمّتها أنّها توجّه الاستعمال اللّغوي الحواري الفعّال نحوَ تحقيقِ أهدافهِ التعاونية: Co Operative Ends))[29]، وقد عُرّف كذلك بأنّه «المعنى التابع للدلالة الأصلية للعبارة، أو ما يرمي إليه المتكلّم بشكل غير مباشر، جاعلاً مستمعه يتجاوز المعنى الظاهر لكلامه إلى معنى آخر»[30].
وممّا مر يمكن تعريف الاستلزام الحواري بأنّه: التوظيف الاستعمالي القصدي، المدلول عليه بمعونة السياق والعقل بشرط توفّر مبدأ التعاون التخاطبي، فعبارة (لا تُسرع يا بابا نحن بانتظارك) الواردة في الإعلام المروري على لسان أبناء سائقي المركبات، لها معنيان:
1ـ المعنى القضوي: وهو الدلالة الظاهرية الحرفية للتركيب، وهي النهي عن الإسراع.
2ـ المعنى المستلزم: التحذير من الأخطار التي قد تترتّب فيما لو وقع حادث للأب نتيجة السرعة المفرطة، أو ربما يكون القصد المستلزم نحن نحبّك.
في إطار بحث العلاقات بين اللغة والمجتمع، اعتنى غرايس بتحليل المعنى تحديداً في نوع خاص من القصد، هو الاتصال Intention-communicative، فالمعنى اللّغوي linguisticmeaning يمكن إدراكه في نطاق ما يقصده المتكلّم من إحداث تاثير معيّن في المتلقّي عن طريق فَهم المستمع لهذا القصد[31].
ولبسط هذه الفكرة ميّز غرايس بين نوعين من المعنى[32]:
الأوّل: سمّاه المعنى الطبيعي Natural meaning= المدلول المطابقي للفظ، وهو دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له اللفظ عينه.
الثاني: المعنى غير الطبيعي Non-Natural Meaning =المدلول الالتزامي للفظ، وهو المعنى الذي يتوصّل إليه المستمع بإعمال العقل والفكر بمعونة السياق.
وعلى هذا فقد كانت بداية الانطلاق عند غرايس هي «أنّ النّاس في حواراتهم قد يقولون ما يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فجعل كل همّه إيضاح الاختلاف بين ما يُقالWhat is said، وبينَ ما يُقصد What is meant، فما يُقال هو ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية face values، وما يُقصد هو ما يُريد المتكلّم أنْ يُبلّغه السامع على نحو غير مباشر اعتماداً على أنّ السامع قادر على أنْ يصل إلى مُراد المتكلّم بما يُتاح له مِن أعراف الاستعمال ووسائل الاستدلال، فأراد أنْ يُقيم معبراً بين ما يحمله القول من معنى صريحExplicitـMeaning، وما يحمله من معنى مُتَضمَّن Inexplicit Meaning، فنشأتْ عنده فكرة الاستلزامImplicature»[33]، فالدلالة هي ما قيل، والاستلزام الحواري هو القصد الذي تمّ إيصاله وتبليغه للمتلقّي، وما قُصِد يختلف عما قيل[34].
إذاً كان من أولى ما اهتمّ به غرايس في عملية التواصل هو كيف يمكن للمتحاورين أنْ يقولا شيئاً ويقصدا شيئاً آخر، أو كيف يسمعان شيئاً ويفهمان شيئاً آخر، وقدْ اكتشف حلاً لهذه الإشكالية سمّاه (مبدأ التعاون Principle ـ Co Operative) بين المتكلّم والمخاطب[35].
2ـ أقسام الاستلزام الحواري
لما كانت نظرية غرايس في المعنى غير الطبيعي تعدّ من أهمّ نظريات التواصل، فهي تكفّلت بتبيان كيفية التواصل في غياب المسالك العرفية أو المباشرة وغيرها؛ المتعارف والمتواضع عليها للوصول إلى مقاصد طرفي عملية تواصل المُرسَل والمُرسَل إليه، فمن المعقول أن نستنتج كثيراً من المعاني عبر استدلالات متعدّده من جملة ما[36]، إلّا أنّ هذه المعاني قد لا تكون مقصودة تواصلياً، ومن هنا يكون الاستلزام الحواري هو استدلال من هذا النوع المقصود بهذه الكيفية[37].
وقد قسّم غرايس الاستلزام على قسمين مختلفين، هما: الاستلزام العام Generalized الذي لا يحتاج إلى سياق حالي معيّن لحصوله، وآخر هو الاستلزام الخاص Particularized وهو ما يتطلّب فهمه وإدراك مكنوناته وجود سياق حالٍ معيّن[38].
وقد ارتأى الباحث لدراسة الاستلزام اللّغوي العام في التمهيد؛ لسببين:
1ـ البحث منطوٍ على دراسة الاستلزامات التخاطبية، وهذا المعنى ليس رائجاً في الاستلزام اللّغوي العام كما سيتضح.
2ـ ندرة النماذج التطبيقية في خطاب المسيرة الحسينية المتضمّنة لهذا النوع من الاستلزام.
ثالثاً: مفهوم الاستلزام اللّغوي العام Generalized
وهو ذلك المعنى المستلزَم لغوياً من غير الحاجة إلى سياق حالي معيّن[39]، والسياق هو «الذي يشمل مكوّنات نصٍّ ما ومحيطه الثقافي والاجتماعي...، فضلاً عن تصوّرات كل من منشئ القول ومستقبله»[40]من خلال عملية التفاعل بين المخاطب والملفوظ الكلامي[41]، إذ أنّ «كل عمل لغوي يغيّر السياق»[42]فالسـؤال يقتـضي إجابة، والاعتراض يطلب جواباً، وبعبارة أخرى: السياق هو نتيجة الأعمال اللّغوية السابقة وعلّة الأعمال اللّاحقة[43].
وهذا القسم الأوّل من الاستلزام عند غرايس، الذي يعنى بالمقاصد الضمنية التي نجدها في العبارات غير الحوارية Conversational- Nonكقول فاطمة بنت الحسين× لأهل الكوفة: «وجعل على بصركم غشاوة فأنتم لا تهتدون»[44]، فقولها المتضمّن تنكير الغشاوة يستلزم ما يلي:
أ ـ المعنى المنطوق (المعنى القضوي): وجعل على بصركم غشاوة (العمى).
ب ـ المفهوم أو القصد المستلزم حوارياً: الغشاوة هنا يراد منها المعنى العام غير المقيّد بأيّ باب من أبواب الضلال، أي: هي كل ما حداهم إلى ارتكاب جريمة قتل الحسين×وأهل بيته، بدلالة قولها (وأنتم لا تهتدون) فإطلاق لفظ الغشاوة الدال على العموم لمجيئه في سياق النفي يقتضي العموم غير التقييدي، وهو معنى مقصود لدى السيدة فاطمة÷؛ إذ أنّها وصفتهم بالضلال المطلق الذي صار حافزاً لهم للإقدام على جريمتهم الكبرى.
فيستلزم من القولة (أ) القولة (ب) بغض النظر عن وجود السياق الحالي المخصوص، إذ أنّ قصد المتكلّم هو الأساس الذي تتفرّع منه دلالة الاستلزام العرفيّ ودلالة الاستلزام غير العرفيّ، وتتفرّع عن دلالة المنطوق دلالة المنطوق الصريح ودلالة المنطوق غير الصريح، في حين تجد أنّ معظم الحوارات التي تستخف بالقواعد والحِكَم تندرج تحت الاستلزام الحواري الخاص؛ إذ الأولى تقتضي المعنى المقصود، وتستلزمه بشكل مستقل نسبياً عن السياق، والأخيرة من بين أصناف الاستلزامات الحوارية التي تكتسب أهمّية خاصّة بالنسبة للسانيات؛ لأنّه من الصعب تمييز هذه الاستلزامات عن المضمون الدلالي للألفاظ، فاقترانها بالألفاظ الملائمة هو أمر مألوف في كل السياقات العادية[45].
ويدخل ضمن هذا النوع الاستلزامات المتعلّقة بمقولة الكمّية ـ التي تحصل بين العبارات التي تندرج على نحو سُلَّميّ من الأكثر إلى الأقل بحيث أنّ السابق يستلزم اللاحق[46]ـالاستلزامات الخطابية الدرجية (السُّلَّميّة)، وهي التي ترتبط بالحمولات الدرجية الجامعة بين المعنى الأقوى وبين المعنى الأضعف الذي يكون جزءاً منه، فحينما تقول: كلُ صلاةٍ عبادةٌ، وهي العبارة الأقوى في الإثبات، والمسمّاة بـ(الموجبة الكلّية) في الدرس المنطقي، يكون التركيب هنا دالاً على العموم الجمعي المتضمّن لكل المصاديق المنضوية تحت عنوان الصلاة، وهذا هو المعنى القضوي الذي تدلّ عليه الهيأة التركيبية بظاهر استعمالها، بيد أنّ هذا المعنى يستلزم معنًى آخر، لا يدلّ عليه ظاهر العبارة الأقوى: بعض الصّلاة عبادة، وذلك:
1ـ لأنّ إثبات الأقوى يقتضي إثبات الأضعف ولا عكس.
2ـ لأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه[47].
أما إذا أُثبتت العبارة الأضعف أو الموجبة الجزئية، كقولك: بعض النّاس أغنياء، فهنا يستلزم مجموعة من المعاني المستفادة لا من ظاهر العبارة ولا من التركيب، بل مستفادة من الاستلزام الحواري لهيأة التركيب الظاهرية، أو مستفادة من المفهوم المدلول عليه من السياق اللّغوي:
ـ بعض النّاس ليسوا بأغنياء.
ـ ليس كل النّاس أغنياءً.
ـ بعض النّاس فقراء.
ـ بعض النّاس ليسوا فقراءً.
ـ كل النّاس إما أغنياء وإما فقراء.
والذي قاد الاستلزام إلى هذه النتيجة هو التحليل التداولي الذي أفضى إلى أنّ المتكلّم في وضع، لا يسمح له بأن يصرّح بما هو أقوى من ذلك، وهو كل النّاس أغنياء، وعندها سيكون خالف الفرع الأوّل من حكمة الكمّية التي تقضي بأن يكون إسهامك في المحادثة مفيداً بالقدر المطلوب، فضلاً عن مبدأ الصدق الذي يتوخّاه المتكلّم، ولو نطق بالعبارة الأقوى، وهي كل النّاس أغنياء؛ لأدّى هذا إلى التضحية بصدق العبارة، وهذا مخالف لمبدأ التعاون، في حين أنّ المتلقّي افترض تعاون المتكلّم معه، أي: إنّه في مقام البيان[48] ـكما يعبّر عنه الأصوليونـومقام البيان أصولياً يقابل مبدأ التعاون عند غرايس، فالمتكلّم التزم بقاعدة الكمّية، والمخاطب أدرك تعاونه وعدم رغبته باستغلال القاعدة وخرقها بلا تنبيهه، ومن ثمّ يُعدّ المتكلّم في مقام البيان والإبلاغ، وأنّه ليس في حال يجيز له بيان الأقوى.
فلو استُعين بالسلالم الهورنية مثل (دائماً، كثيراً، أحياناً) لوجد أنّ هذا السلّم المتدرّج، ينتج الاستلزام السُّلَّمِيّ، وأساس هذا الاستلزام هو أنّ المتكلّم عندما يتحدّث بأيّ جملة مستعملاً أحد التعابير السُّلَّمِيّة، فإنّه يستلزم نفي أيّة جملة تحتوي أيّاً من العبارات السُّلَّمِيّة الموجودة على يمين ذلك التعبير، فتأكيد (أحياناً) يلغي كل الجمل التي تعتمد فيها التعابير الموجودة على يمين (أحياناً)، وهي جملة «كثيراً ما، أو دائماً»، ذلك لأنّ صدق التركيب المستلزم يقع في أولويات الاستلزام الحواري، والقول بإثبات التعابير المنافية للجملة المدروسة قد يؤول إلى كذب المعنى المستلزم، وهكذا الحال مع باقي التعابير في معظم السّلالم[49].
بعدما تبيّن أنّ صور الاستلزام اللّغوي العام ومصاديقه تتجلّى عبر:
أولاً: استلزام لغوي عام متعارف، لا يحتاج إلى سياق حالي خاص، ويتحقق بطريقين:
ـ سُّلَّمِيّ (كل، وبعض، وجميع، وعامة...).
ـ جُمليّ (أدوات العطف، فاء السببية).
ثانيا: استلزام عام (غير متعارف وغير وضعيّ) مجازيّ.
ثالثا: استلزام عرفيّ ناتج عن بعض الألفاظ المعجمية (النكرة، لكن، لذلك، الضمير)
أ ـ السُّلّمِيّ (كل وبعض، وجميع...).
أ/1ـ كل: اسم يفيدالاستغراقوالإحاطة بالأفراد والأجزاء، وهو«اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر»[50]، و(كل) إذا أضيف إلى النكرة أفاد استغراق جميع أفراد جنسه، وهو لفظ معناه بحسب ما يضاف إليه، وحكمه الإفراد والتنكير، فإذا كان مضافاً إلى نكرة وجب مراعاة معناه[51]، ومما يقارب هذا المعنى قول الإمام الحسين×: «وليأخذ كلُّ واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرّقوا في سواد هذا اللّيل، وذروني وهؤلاء القوم، فإنّهم لا يريدون غيري»[52]، فالخطاب ـ كما يتضح ـ موجّه إلى كل أصحابه الحاضرين معه ليلة العاشر من المحرّم، وهو زمن التفوّه بالخطاب، ولا يستثني منهم أحداً، لاسيما حين جاءت كلمة (كل) مضافة إلى نكرة؛ لكي تعطي معنى العموم الاستغراقي غير المستثني لأحد من الأفراد المخاطبين، وهو خطاب تحاوري يحمل معنى الأمر الحقيقي الصادر من الرتبة العالية إلى الرتبة الدانية، استعمل فيه الإمام صيغة الأمر المعروفة وهي الفعل المضارع بملاصقة لام الأمر الدالة على الأمر الصريح.
وقول الإمام السجّاد× في الشام: «أسد الله الغالب، مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، ذاك جدّي علي بن أبي طالب»[53] فاستلزمت كل، بعض، أي: أن يأخذ بعضكم بيد بعض، إذ يرتبط مفهوم السُّلَّم الكمّيّ بعلاقة المحمول الأقوى بالمحمول الأضعف، فإذا أطلق المحمول الأقوى استلزم منه حوارياً المحمول الأضعف[54].
أ/2ـ كثير: الكثرة: نقيض القلّة، والكثرة نماء العدد: يقال كَثُر الشيء يكثر كثرة فهو كثير[55]، ومن هذا المعنى قول السيدة زينب‘، وهي تخاطب أهل الكوفة: «إي ـواللهـفابكوا كثيراً، واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها...»[56]، فلقد أدّى الخطاب الزينبي فعلاً لُغوياً مباشراً، والمدلول عليه من القرينة الظاهرية للفظ التركيبي؛ هو فعل الأمر: (ابكوا واضحكوا)؛ حيث زاوجت بين فعلين متغايرين لفظاً ودلالةً من خلال التنويع الطباقيّ، بيد أنّ هذا التوفيق بين الفعلين أنجز ـ إجرائياً ـ فعلاً كلامياً غير مباشر استلزم منه الاستخفاف والتوبيخ، لا سيّما حين دراسة الظروف التي كانت وراء إلقاء الخطاب.
أ/3ـ قلّة: وهي من أقلّ: افتقر، يقل ّ إقلالاً، والإقلال: قلّة الجدة، وقلّ ماله[57]، وهي لفظ نقيض الكثرة، ويستلزم منها الضعف والافتقار والعَوَز، ومما يقارب هذا المعنى قوله×: «ألا وإنّي زاحف بهذه الأسرة على قلَّة العدد وخذلان الناصر»[58]، وفيه من المعاني المستلزمة لغوياً:
·إنّه×قد أقدم على مصيره المحتوم بنفسه؛ أي لم يكن ينتظر الشهادة، بل هو من اختارها، والذي يرشّح هذا المعنى قوله×: «وخِير لي مصرع أنا لاقيه»، في حين أنّ الناموس الطبيعي للموت هو من يختار بلا إرادة من البشر، وهذه حقيقة وضّحها القرآن الكريم جليّاً كما في الآية الشريفة (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)[59].
·الثُلّة التي معه ليس فيهم من هو ضنين بنفسه على إمامه، ولذا يتكلّم عنهم الحسين× بأسلوب المتيقّن فيهم.
·القلّة هنا لم تكن بمعناها الحرفيّ؛ لأنّ الحسين× وأهل بيته وصحبه كان عددهم يتجاوز المائة فارس، ولكن لفظ القلّة هنا استلزم ضخامة الجيش المعادي إلى الحد الذي صار عددهم جميعاً قلّة في قباله.
·وصف أصحابه بالأسرة؛ كونهم قد أثبتوا له سيرهم على ما سار عليه، بلا انهزام أو خوف أو وجل.
أ/4ـ جميع: لفظ يفيد التوكيد المعنوي للجمع بشرط الإضافة إلى الضمير المؤكّد، وهي تشبه (كل) في جميع حالاتها، إلّا أنّ التوكيد بها لا يفيد اتحاد الوقت إلا بقرينة؛ كما لا يمنع ذلك[60]، وتختلف عن (كل) من جهة قصديّتها على الإحاطة والعموم، فهي تدلّ على عموم الإفراد على سبيل الاجتماع، بخلاف (كل) التي تعمّ الأشياء على نحو الإفراد والإحاطة[61]، و(جميع) على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) يقال: «حي جميع وجاؤا جميعاً»[62]، أي: كلّهم وليسوا مجتمعين.
ولعلّ هذا المعنى هو المقصود في قول الإمام الحسين×: «ألا وإني لأظنّ يوماً لنا من هؤلاء، ألا وإني قد أذنت لكم، فانطلقوا جميعاً في حلٍّ، ليس عليكم منِّي ذمام، وهذا اللّيلُ قدْ غشيكم فاتخذوه جملاً» وهنا استلزم كلام الإمام× الرخصة لهم جميعاً، أي: كلّهم، وليس الانطلاقُ مجتمعين[63]، ففي كلامه إذن عام كي يتركوه إن شاءوا، فطلبه مبني على الترخيص بالرحيل لا الأمر، بدلالة قوله «أذنت لكم»؛ ولذا جاء ردّهم له بالامتناع عن تركهم له مهما كانت الظروف والنتائج.
ب ـ الجملي (أدوات العطف، وفاء السببية)
ومما ينضوي تحت الاستلزام اللّغوي العام، ما تحمله بعض أدوات العطف من معانٍ مستلزمة من دلالتها الحرفيّة المعبّرة عن قصد المتكلّم ومراده، ويمكن التدليل على ذلك باستعمال ثلاث أدوات.
ب/1 ـ ما يستلزمه حرف العطف (أو) عندما يأتي بمعنى التخيير «وهي الواقعة بعد الطلب، وقبل ما يمتنع فيه الجمع»[64]، ويستلزم منه امتناع الجمع، ومما يقارب هذا المعنى قول الإمام الحسين×: «ويلكم، أتطلبوني بدم أحدٍ منكم قتلته، أو بمالٍ استملكتُهُ، أو بقصاصٍ من جراحاتٍ استهلكته، فسكتوا عنه لايجيبونه»[65].
استلزم امتناع الجمع؛ لأنّ
الإمام× لا يمكن
أن تصدر منه إحدى هذه الأسباب الموجبة لقتله، أو الاقتصاص منه، ومما يعضد هذا
القصد هو سكوتهم وإحجامهم عن جوابه×. ومن هنا، فالتخيير العطفي ـ الممتنع على مثل الحسين× ـ الذي
استعمله الإمام ليس لاستنطاقهم، بل لإحجاجهم، فهو عطف سياقيّ ـ قصديّ ـ اقتضى
إلزام الخصم الحجّة؛ لأنّهم يعلمون أنّ الحسين×بعيد عن
هذه التّهم التي ذكرها، ولو كان كذلك لذكروه، ولذا جاء جوابهم لاحقاً ـ حين ألزمهم
الحسين× الحجّة ـ
بقولهم: «إنّنا نقتلك بغضاً منّا لأبيك»[66]، وهذا
الجواب كاشف عن مكنون صدورهم الفاسدة؛ لأنّ البغض يقتضي استحقاق المبغوض له، وهذا
الاستحقاق غير موجود في علي×،
بل بغضهم له بسبب صدورهم الموغرة حقداً عليه،
ولذا قالوا «بغضاً
منّا لأبيك» فعليٌ×غير
مستحقّ للبغض، بل قلوبهم لا تستحقّ حبّه.
والمقاربة الأخرى لأداة العطف (أو) التي جاءت بمعنى التخيير، هو استلزامها لجواز الجمع، مع كونها سبقت بطلب[67] قوله×: «سلوا جابرَ بن عبد الله الأنصاري، أو أبا سعيدٍ الخدري، أو سَهلَ بن سعد الساعدي، أو زيد بن أرقم أو أنسَ بن مالك، يخبروكم: أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله’ لي ولأخي... »[68]، فقد وجّه الإمام× الخصم إلى تحييده؛ كي يعرف حقيقة الحسين إن كانت شخصيته غائبة عن المتلقّي، وهذا الأمر كالسهم الأخير في كنانته× تجاه إقناعهم بالإحجام عن قتلهم إيّاه بعدما يتعرّفون عليه من خلال الشخصيات التي ذكرها، مع أنّه يعلم أن القوم لن يتوانوا عن قتله حتى لو اجتمعت تلك الشخصيات معاً في ذلك اليوم، وشهدوا بما قال الحسين×، فـ(أو) هنا استلزمت الجمع؛ لأنّ السؤال قد يقع على الجميع، مع أنّ ماهية دلالتها الحرفية هي التخيير، والذي يرشّح معنى الجمع هو قوله: «يخبروكم أنّهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله’ لي ولأخي».
ب/2ـ فاء السببية: وهي تستلزم كون ما قبلها سبباً لما بعدها[69]، قال×: «تبّاً لكم أيّتها الجماعة وترحاً وبؤساً لكم، حين استصرختمونا والهين، فأصرخناكم موجفين، فشحذتم علينا سيفاً كان في أيدينا، وحمشتم علينا ناراً أضرمناها على عدوّكم وعدوّنا، فأصبحتم إلباً على أوليائكم، ويداً على أعدائكم من غير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، ولا ذنب كان منّا إليكم»[70]، فجاء الاستنجاد الذي عبّر عنه الإمام× بالاستصراخ الذي كان صادراً عن ولهٍ؛ أي: شدّة الحب هو السبب الذي كان وراء نجدتكم على وجه السرعة، أداءً للتكليف الشرعيّ، وطلباً لإغاثة الملهوف فضلاً عن المحبّ، والأداة (فاء السببية) هي من استلزمت هذا القصد، وإلّا فدلالتها الحرفية هي إفادة العطف مع التعقيب. ثم إنّ هذا النوع من التكرار للفاء، واستعمالها بهذه الطريقة في الخطاب، لهو نوع لطيف وأسلوب رشيق من لسان العرب[71].
ثانيا: استلزام عرفي ناتج عن دلالة الألفاظ التي لا تنفكُّ عن المضمون الدلالي بالوضع، وهو نوع آخر من الاستدلال غير المشروط بالصدق[72]، أسماه غرايس الاستلزام العرفي Conventional Implicature، وهو استلزام يستفاد من دلالة المفردات المعجمية أو العرفBy Convenional، إذ لا يتعلّق بالاستلزامات غير العرفية، ولا بحِكَم وقواعد الحوار الناتجة عن مبدأ التعاون أو بقواعد إضافية، بل بالألفاظ المعجمية نفسها، بحيث لو غيّرنا تلك الألفاظ يزول التلويح تماماً؛ لأنّه لصيق بها، كما أنّه يعدّ من مستتبعات التركيب، وبهذا هو يخالف أحد مميّزات الاستلزام الحواري، وهي عدم إمكانية الفصل بتغيير الألفاظ، فكلمة (لكن) لها شروط الصدق المنطقية نفسها، المتعلّقة بشرط الصدق لحرف العطف (الواو) إلّا أنّها تفيد استلزاماً عرفياً مضافاً إلى تلك الشروط، فمضمونه حصول تناقض بين المعطوفين، ومثلها (النكرة ـ لكن ـ لذلك ـ إذن ـ أي الكمالية)[73].
أـ النكرة: هي كلّ ما دلّ على غير معيّنٍ، خلافاً للمعرفة، وهي أشدُّ تمكّناً من المعرفة[74]، وهي الأصل في الأسماء[75]. ومما يقارب هذا المفهوم في خطب المسيرة الحسينية تداولياً خطاب الإمام الحسين× ليلة العاشر، فقد روى عن علي بن الحسين×، قال: «جمع الحسين× أصحابه بعدما رجع عمر بن سعد، وذلك عند قرب المساء، قال علي بن الحسين: فدنوت منه لأسمع ـوأنا مريضـفسمعت أبي وهو يقول لأصحابه: أثنى على الله تبارك وتعالى أحسن الثناء، وأحمده على السرّاء والضرّاء، اللهم اني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوّة، وعلّمتنا القرآن...، أما بعد، فإني لا أعلم أصحاباً أولى ولا خيراً من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عنّي جميعاً خيراً...»[76].
يستلزم من استعمال النكرة في حيّز النفي دلالتها على الإطلاق والعموم[77] لكلّ من حضر ليلة العاشر من أصحابه×، ويمكن أن نستدلّ على عموميّتها، وإطلاقها على جميع أصحابه سواء من اصطحبه من بداية المسيرة، أم من لحق به في منتصف الطريق، أم من التحق به في اللحظات الأخيرة، بملاحظة ضميمتين:
الضميمة الأولى: هي كون الإمام× يعلم بمن سيلتحق به، وهناك من الأدلة التاريخية ما يثبت أنّ الإمام× كانت لديه صحيفة بأسماء أصحابه، ومنها ما حصل مع زهير بن القين[78]، أنّ كل أصحابه كانوا على هذا المستوى العالي من الوفاء
الضميمة الثانية: وهي المقصود مَن اتصف بتلك الأوصاف وتُسمّى عند الأصوليين: التجريد عن الخصوصية أو إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط[79][80]، بمعنى أنّ ما ذكر في خطاب الإمام×في تلك الليلة هو من باب المثال، وإلّا فما ذكره الإمام× من أوصاف يمكن تعديتها من مورد النص وهو المتلقّي المباشر للخطاب، وهم من صحب الإمام×وحضر تلك الليلة، الذي خُصّ بمجموعة من الأوصاف تشمل كل أصحابه، والدليل على إلغاء الخصوصية هو العرف، فمثلاً ورد في الروايات في حال تنجّس الثوب بنجاسة فحكمه الغسل بالماء القليل مرّتين، هذا فيما ذكر للثوب، أما الجورب وهو لا يصدق عليه أنّه ثوب فالعرف يذهب إلى عدم الفرق، وإلّا فالقصد أن يصيب الشيء[81].
ب ـ لكن: فعل كلامي لغوي مباشر، دلالته الحرفية الاستدراك، له شروط الصدق المنطقية نفسها المتعلّقه بشرط الصدق لحرف العطف (الواو) إلّا أنّها تفيد استلزاماً عرفياً مضافاً إلى تلك الشروط، فمضمونه حصول تناقض بين المعطوفين[82]، وتتضح تجلّيات هذا الاستلزام الحواري في بعض الحواريات التي حصلت منذ انطلاق المسيرة الخالدة وبعدها، من قبيل ما دار بين الإمام الحسين× والوليد عامل بني أمية في المدينة من حوار، حين أقبل الإمام× على إنهاء الحوار، وأخبره عن عزمه وإصراره على رفض البيعة ليزيد، قائلاً: «أيّها الأمير، إنّا أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله، وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أيّنا أحقّ بالبيعة والخلافة»[83]، فقد وفّر الإمام× جوّاً سياقياً لا يتناغم مع الجوّ المستفاد من ظاهر الحوار، بخلق توليفة استعمالية يُفهم منها ما ينافي الظاهر التركيبي مما يستلزم حصول تنافر أو تناقض بين طرفي الخطاب، وإلّا فموقف الإمام× واضح من إباء البيعة كما يجلوها الشقّ الأوّل من المحاورة الإجرائية، إذ هو واضح من المقابلة بين صفاته وصفات يزيد، إلّا أنّ الإمام× قصد إيهام الوليد بـ(لكن) التي تستدعي عرفاً أن المتلقّي لم يكن يتوقّع الرفض[84]، في حين الإمام× جاء بـ(لكن) لزيادة الإمعان في رفض البيعة، والتأكيد على إصراره المستفاد من سياق النص الحواري، وهذا الأسلوب قريب جدّاً مما يعرف في الدرس البلاغي بـ(المدح بما يشبه الذم)، حين يأتي سياق المدح مستثنى بسياق آخر، يوهم السامع بأنّه سيفضي إلى الذمّ في حين أنّه يعقبه بمدح جديد، كقول النابغة الذبياني:
|
ولا عيبَ فيهم غير أنَّ سيوفهم |
ومن الاستلزام العرفي الدلالة على المنزلة الاجتماعية المستعملة ببعض الألفاظ[86]. ومنها ما جاء عن الإمام الحسين×في احتجاجه على أهل الكوفة بكربلاء، لما أحاط النّاس بالحسين×ركب فرسه واستنصت النّاس، حمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: «تبّاً لكم أيّتها الجماعة وترحاً وبؤساً لكم، حين استصرختمونا ولهين، فأصرخناكم موجفين، فشحذتم علينا سيفاً كان في أيدينا، وحششتم علينا ناراً اقتدحناها على عدوّكم وعدوّنا، فأصبحتم إلباً على أوليائكم، ويداً على أعدائكم من غير عدل أفشوه فيكم، ولا أمل أصبح لكم فيهم، ولا ذنب كان منّا إليكم»[87].
هنا استلزام عرفي ترشّح عن الضمير (نا)، وهو ضمير يفيد الجمع للدلالة على المنزلة الاجتماعية الدالّة على علوّ منزلة المخاطب، وإلّا لا يوجد فرق بين لاحقة يا المتكلّم وبين الضمير (نا)[88] لو قال:
|
استصرختموني |
|
|
|
فأصرختكم |
|
أصرخناكم |
|
بيـدي |
|
بأيدينا |
|
علي |
|
علينا |
وبين لاحقة الضمير (نا) من حيث المعطى القضوي ما دامت شروط الصدق متوافرة في كلا الاستعمالين، إنّما الاختلاف بينهما راجع إلى الاستلزام العرفي الراجع للاحقة الضمير (نا) الدال على الجمع، كي يعطي دلالة توقير، واحترام، وتبجيل، لا تظهرها لاحقة (ياء) المتكلّم الدالّة على الإفراد، المستوحاة من الدلالة العرفية الاجتماعية، والإمام× في المحاورة الآنفة لم يخرج عن طبيعة البيئة الاستعمالية للضمائر الدالّة على المكانة الاجتماعية التي يتمتّع بها في تلكم الفترة، ولعلّ هذا لم يكن واضحاً عند بعض سامعيه، لذا صار يؤدّي رسالته لهم بهذا التنوّع الأسلوبي في الضمائر؛ كي يوصل بعداً تعريفياً لهم عن مكانته الدينية والاجتماعية.
هو الذي يبتني عند غرايس على أربع قواعد وتفريعاتها من الحكم أو المبادئ
التي أخذها من كانط، التي هي الكم والكيف
والمناسبة والطريقة[89]، فالقواعد إذاً ـكما
يرى
غرايسـليست
وسائل تأتي عفو الخاطر، بل هي رؤى عقلية لتيسير التبادل التعاوني التواصلي[90]، ويرى
غرايس أنّ الاستلزام الحواري يجب أن يكون مما نستطيع التوصّل إليه وإقامة الحجّة
عليه؛ لأنّه حتى إن تمكّنا من استنتاج الاستلزام وجدانياً أو حدسياً فلا يمكن
اعتباره ـ إن وجد أصلاً ـ استلزاماً حوارياً، فهو سيكون استلزاماً عاماً وضعياً[91].
الاستلزام الحواري في ضوء قاعدة الكم
بعد أن اهتمّ غرايس في كيفية التفريق بين ما يقوله المتحاوران وبين
قصدهما، وبين ما يَسمعانه وما يَفهمانه من خلال مبدأ
سمّاه بـ(مبدأ التعاون)
(Operative- Co Principle) بين المتكلّم والمخاطب[92]، بقي أن يفهم القارئ أنّ مبدأ
التعاون هو ذلك المبدأ الذي يلزمك بأن تتقيّد بغايتين[93]:
الغاية الأولى: هي أنْ تكون متفاعلاً في الحوار بمقدار ما يطلب منك في أثناء عملية التخاطب في مقام المساهمة أو التفاعل.
الغاية الثانية: أنْ يكون الدافع والحافز هو غاية الحوار المتبادل، وإلى أين يسير التخاطب؟ فكلٌ من طرفي الحوار ملزم بهاتين الغايتين في لحظة معينة.
يتأسّس الاستلزام الحواري عند (غرايس) على أربع قواعد مع تفريعاتها من الحِكَم أو المبادئ[94]. ومن المفيد الإحاطة بتلك القواعد ليتسنّى في ضوئها دراسة خطاب المسيرة الحسينية، الذي غايته إيصال المعنى غير الطبيعي، عبر تلك القواعد والمبادئ[95]:
1ـ قاعدةُ الكم (Maxim Of Quantity): [96]وقد عدّها غرايس حدّاً دلالياً فاصلاً بين الزيادة والنُقصان عند المتحاورين في مقدار الفائدة المرجوّة، ويكون على قسمين:
الأوّل: حصول الفائدة على قدر الحاجة.
الثاني: يجب أنْ لا تتجاوز الفائدة الحد المطلوب.
لاحترام هذه المقولة أو الحكمة يستلزم من المتكلّم تهيئة كمّية من المعلومات المناسبة، وتقديمها للخبر الذي هو بصدده من غير زيادة أو نقصان فيها؛ ذلك لنجاح التواصل، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مصطلح الكم لا يُقصد به عدد الكلمات، كما قد يتوهّم بعض الدارسين، بل المقصود هو وفرة المعلومات التي يقدّمها المتكلّم بلا زيادة أو نقصان، بغض النظر عن عدد الكلمات المُعدّة لتحقيق الغرض الإبلاغي في ضوء مبدأ التعاون، وهو القصد، وما يتحقق بـ[97]:
1ـ أن نجعل إسهامنا بالقدر المطلوب.
2ـ أن لا نقدّم نقصاً في المعلومات.
ومن مصاديق احترام قاعدة الكم:
أولاً: توخّي الدقّة الموضوعيّة في الحوار
يقدّم المتكلّم خطابه بوصفه ردّة فعل، أو انعكاساً لظروف ومجريات وأحداث وعوامل نفسية، تتعاضد على بلورة الحوار وإخراج الكلام[98]، ومما يقارب هذه القاعدة في خطب المسيرة الحسينية توخيّ الإمام الحسين×في قوله لأخيه محمّد بن الحنفية ـ الذي كان قد نصح الإمام× بالعدول عن الذهاب إلى العراق ـ توظيفالتودّد والأُلفة الخطابيين، فيقع الخطاب الحسيني بشحنته العاطفية موقعاً ارتضائياً من نفوس سامعيه، إذ قال له الإمام×: «يا أخي، جزاك الله خيراً، لقد نصحت وأشرت بالصواب، وأنا عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيّأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، أمرهم أمري ورأيهم رأيي، وأمّا أنت فلا عليك أن تقيم في المدينة، فتكون لي عيناً لا تخفي عني شيئاً من أمورهم»[99].
فلقد عمل×على بيان معطيات التضامن التخاطبي الإجرائي بالقدر المطلوب، من غير زيادة أو نقصان في توليفته الجوابية على خلق أجواء المحايثة التآلفية بينه وبين المستقبِل، وذلك بالاتّكاء على التوظيف الكمّي والنوعي للإنتاج اللّغوي والالتزام بحكمتي (الكم والكيف) مع توفّر مبدأ التعاون على وفق نظرية غرايس، الذي جاء عليه الخطاب مستفيداً من القبليات التي عليها المستقبِل، والتي تُعطي للمنتج لا بُدّية التودّد والتحبّب في إرسال الخطاب. فالتوظيف الكمّي يتجلّى في الاسترسال الخطابي والإطناب في بيان المآل المصيري لهذا الخروج الحسيني، الذي لا يضرّ بحقيقة الإجابة لو جاء الخبر مقتضباً، لكنَّ خاصّية التحبّب للمستقبِل تجعل المنتج يأتي بإجراءات سردية للتدليل على المحايثة التآلفية مع متلقّيه، ولعلّ هذه البيانات التطمينية التي تصدّرها الخطاب لم تكن مرادةً للمتلقّي، لكنّها تقع في جو تضامني، تجعل المرسل مدفوعاً عاطفياً للاسترسال.
تضمّن توظيف الإمام الحسين×الكمّي بيانات عدّة:
1ـ الشكر على النصح، وكذلك الدعاء له.
2ـ الإصرار على الخروج.
3ـ التهيّؤ للخروج والإعداد له.
4ـ الخروج بصحبة إخوته وشيعته.
5ـ ترخيص الإمام لأخيه بعدم الخروج.
6ـ الترخيص كان مشروطاً بشرط تضامني، فقد قال× له: «تكون عيني» وفي هذا إشارة إلى أنّه جزء منه، وهذه المعايير لم تكن قد طُلبت من المستقبِل، ولكنّها مقتضيات تضامنية.
أما التوظيف النوعي: فقد تضمّن خطابه× عبارات صادقة صادحة وطافحة بالشحن العاطفي، من قبيل:
ـ يا أخي
ـ جزاك الله خيراً
ـ فتكون عيني
ـ نصحتَ، أشرت بالصواب
فهو يصدر خطابه بـ(يا أخي)، وهو صادق[100] ومعتقدٌ بكل تعبير، كي يُعطي للمتلقّي المباشر (محمد بن الحنفية) والمتلقّي غير المباشر أنّ الخطاب منطوٍ على بعده التودّدي حسب قاعدة التعفّف، لا سيما أنّ الخطاب وصل مكتوباً للمتلقّين، فيتعيّن التوظيف العاطفي؛ كي يُعبّر عن حالة من التضامن الإجرائي بين المرسِل والمستقبِل، ولولا عبارات الشحن العاطفي هذه لفُسّر الخطاب على تأويلات مغايرة.
ومما يقارب إطاعة القاعدة واحترامها حوارية حصلت بعد استشهاد الإمام الحسين× سنة 61هـ بين أخته زينب‘ وعبيد الله بن مرجانة، بعد أن أدخل عيال الحسين× إلى قصر الكوفة، وكانت زينب÷في جملتهم متنكّرة بأبسط ثيابها، جلست في إحدى جوانب القصر، وقد حفّت بها إماؤها.
ـ فقال ابن زياد: من هذه التي انحازت ناحية ومعها إماؤها؟
ـ فلم تجبه زينب‘.
ـ ابن زياد أعاد السؤال ثانية وثالثة.
ـ فقيل له: هذه زينب‘ بنت علي×[101].
وقبل الولوج في دراسة الحوارية على وفق المنهج التداولي لتحليل الخطاب، لا بدّ من التعرّف إلى الظروف المحيطة التي اكتنفت الحوار؛ إذ لم تكن متكافئة على أكثر من صعيد:
أ ـ الصعيد القيمي: جاءت الحوارية متفاوته ـ الشخصيات ـ بين الفضيلة والرذيلة، بين القداسة والرجس، بين ربيبة الوحي عقيلة بني هاشم وبين الدعي ابن الدعي.
ب ـ الصعيد المادي: كان جيش الخصم متوهّماً النصر، في حين أنّ جيش الحسين× هو من كان منتصراً، وإن بدا خلاف ذلك في الظاهر.
ج ـ الصعيد النفسي: كان ابن مرجانة منتشياً بفرحة النصر، وشامتاً في قبال الوضع النفسي المأساوي الذي كانت عليه رائدة المسيرة السيدة زينب (عليها السلام)، والذي تمثّل بـ:
ـ فقدانها لثمانية عشر رجلاً من أهل بيتها، وأمامها الرؤوس المحمولة على الرماح، لاسيما رأس الإمام الحسين× مضرّجاً بدمه.
ـ إشرافها على نساء أنهكهن المصاب، وأطفال عرفوا لتوهم إحساس اليتم؛ مما يجعلهم أكثر إنكساراً.
ـ إقتداءها ومن معها مكبّلين إلى الكوفة، وقد أخذ منهم التعب مأخذه.
ـ ترقبهم لأي عاقبة إذا ما نطق أحدهم بكلمة مغايرة لهوى ابن زياد؛ إذ كان سيف الظلم مسلّطاً على رقابهم.
أما تتمّة الحوارية فجاءت كالآتي:
ـ قال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم، وقتلكم، وأكذب أحدوثتكم.
ـ فقالت زينب÷: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيّه’، وطهّرنا من الرجس تطهيراً، وإنّما يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر، وهو غيرنا[102]. ومن المقابلة بين كلمات طرفي الحوار:
ابن زياد: الحمد لله
زينب: الحمد لله
ابن زياد: فضحكم
زينب: يفتضح الكاذب
ابن زياد: قتلكم وأكذب أحدوثتكم
زينب: يكذب الفاجر وهو غيرنا.
وفي ضوء آليات تحليل الخطاب يلاحظ أنّ هناك استلزاماً حوارياً أنموذجياً، إذ تجلّى بالاتساق بين الرسالة والواقع (المقام) وبين المرسل إليه كماً وكيفاً وملاءمة وطريقة[103]؛ إذ كانت سمة الاتّساق بمنزلة المسوّغات ـ لاحترام القواعد ـ التي توخّى المتكلّم (السيدة زينب‘) الردّ من خلالها على تجاوزات عبيد الله وادعاءاته الباطلة، وذلك بالمقدار اللازم الذي يفرضه الواجب والتكليف الشرعي. إذ تمتلك السيدة زينب‘ دليلاً على صحّة (الكيف) ردودها في رد ودفع الشُبهات التي حاول عبيد الله ـ متعمداً ـ إيصالها لمن حوله، علاوة على أن تلك المعلومات (الرسالة أو المقول) قد جاءت متّسقة مع المقام متوافقة مع مبدأ الملاءمة. وعليه استلزم احترام المتكلّم لهذه القواعد والتزامه بها، إبطال كلام المخاطب (عبيد الله بن زياد) وردّ تهكّمه[104].
ويمكن استنتاج أكثر من قصد في ظلّ هذه الظروف وعبر إحدى آليات التداول التخاطبي المتمثّلة بمبدأ التعاون والقواعد المتفرّعة عنه كإطاعة قاعدة (الكم، والكيف والمناسبة):
أ ـ قصد الخصم (عبيد الله بن زياد) من حواره مع السيدة زينب‘:
أ/1ـ إظهار شماتته بوضوح من خلال خطابه.
أ/2ـ إظهار قوّته والتبجّح بالنّصر أمام امرأة منكسرة، بحسب الظرف الطبيعي الذي تكون عليه النّاس عامّة، فضلاً عن المرأة التي فقدت كل أهل بيتها.
أ/3ـ إظهار البعد العقديّ المغلوط الذي كان يركّز عليه بنو أميّة، وهو (الجبر)؛ أي أنّنا قتلنا أهل بيتكِ بأمر من الله، وما قمنا به ما هو إلا عمل بأمر الله.
أ/4ـ إيهام المجتمع بأنّ هؤلاء قد خرجوا على إمام زمانهم، ففضحهم الله على يده بالهزيمة والقتل والسبي.
أ/5ـ التركيز على تكذيب دعوى النبي’ وهذا مرتّكز في عقلية بني أمية، فأبو سفيان كان يقول ـ حين انتهت إليهم الخلافةـ: «يا بني أميّة، تلقّفوها تلقّف الكرة، والذي يحلف به أبو سفيان، ما من جنّة ولا نار»[105] وأكّد هذا المعنى يزيد حين تمثّل قائلاً: فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
أ/6ـ أراد ابن زياد نسف المعتقد من أساسه، فتوجّه إلى أسّ القضية والموضوع من خلال إضفاء الشرعيّة على حكومة يزيد.
أ/7ـ حاول إيهام النّاس والمجتمع الكوفي بأنّه مؤمن بالله ورسوله، فابتدأ بالحمد والثناء، وحاول الظهور بمظهر الدين والتقوى. حيث يمكن التفريق بين معنيين لمفاد كلامه هذا.
المعنى القضوي: وهو الحمد والثناء لله تعالى والصلاة على النبي، الذي تضمّنه
معنى المحتوى القضوي.
المعنى المستلزم: وهو إضفاء المشروعية على فعله الإجرامي. حيث أُبطل هذا القصد المستلزم من خلال ردّ السيدة زينب‘، الذي انطوى على مضامين حجاجية عالية، أفهمت المتلقّي حقيقة ما تقوم به السلطة الحاكمة وبشاعته، من تغيير لشريعة الله وسنّة جدّها، وكذلك هتك للحرمات من قتل للنفس المحترمة، وغصب أموال المسلمين، والتحكّم بمقدّراتهم.
ب ـ المقاصد التي أرادت السيدة زينب‘إيصالها للمتلقّي من خلال كلماتها تُبيّن العكس، إذ ردّت ادعاءه ردّاً منطقياً حجاجياً، جعلته يستشيط غضباً، فبعد أن حمدت الله وأثنت عليه (جلّ شأنه)، الذي منّ على آل بيت نبيّه محمد’؛ تراءت حجّتها الظاهرة التي لا ينكرها عاقل، ثمّ ساقت كلامها في حجّة موجّهة، ودليل آخر يستوجب عليها الثناء والشكر لله، فبدت حجّتها أقوى من الحجّة الظاهرة بدرجات؛ حيث يمكن رصد ذلك من خلال:
ب/1ـ اعتبارها لمقام المدّعي، قصداً وفعلاً[106]، والتركيز على أنّ بيت فاطمة مطهّر من الرجس، في قبال بعض البيوت، وهذا ما أكّده سياق الآية(ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)[107]، فإنّه سياق واحد متصل، لوّحت من خلاله بتذكيره بقوله تعالى، وردّه بالحجّة.
ب/2ـ أثبتت الأساس، وهو أنّ النبي’ جدّهم، ومن ثمّ فضحت ابن مرجانه ومن ولّاه، عبر بيان حقيقة كفرهم وعدم إيمانهم برسالة جدّها’ وأهل بيته الطاهرين^، بل هم على سيرة معاوية والبيت الأُموي.
ب/3ـ بيّنت له وللحاضرين بقولها «إنّما بدين جدّي اهتديت أنت ومن ولّاك وأبوه»، أنّ سبب اهتدائك إلى الإسلام هو رسالة جدّي التي لولاها لبقيتم في كفركم وضلالكم.
ب/4 ـ رفعت‘ الغطاء عن قصدها أكثر وعبر آليات الحوار التخاطبية، التي اهتمّت بالجانب التبليغي المساوق لمبدأ التهذيب[108]أو مبدأ التأدّب كما أسمته روبن لاكوف في مقالتها الشهيرة: (منطق التأدب)[109]؛ لأنّ «الخطاب نظام أو بنية تفاعلية، تنبني على نوعين من المبادئ: نوع تبليغي، وآخر تهذيبي، وأنّ هذه المبادئ تتفاضل فيما بينها تبعاً للغاية والوظيفة المتوخّاة من الخطاب»[110]، فاستطاعت‘ أن تُفحم الخصم عبر تسلّطها على ناصية اللغة باستعمال بعض الأساليب التي جانبت معناها الحقيقي، من قبيل:
ـ أسلوب القصر بـ(إنّما) وهو (تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص)[111] فمن المعلوم أنّ للقصر أحوالاً تختلف بحسب أحوال من يُوجّه له الكلام، فهي أربعة أقسام عند البلاغيين، فقد يُوجّه لمن يراد إعلامه بمضمونه وهو خالي الذهن، أو يراد رفع شكّه وتردّده، أو تصحيح تصوّره الذي هو مخطئ فيه بحسب اعتقاد موجِّه الكلام[112]، كما هي عليه حال السيدة‘ بقولها: «وإنّما يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر، وهو غيرنا، يا عدوّ الله» فقصرت‘ كل موصوف بالفاسق على الافتضاح، والفِسْقُ: الخروج عن الأَمر، و(ففَسَقَ عن أَمر ربّه) أَي: خرج[113]. ومن هنا استلزم استعمال أسلوب القصر بمعونة السياق والقرائن الحالية قصد التعريض بعبيد الله بن زياد، وبكل من خرج على سنّة أبيها وجدّها÷.
ويستلزم مما تقدّم الآتي:
1ـ أشارت‘ إليه بالفسق، فكل من خرج عن سيرة النبي’، وقتل أهل بيته فهو فاسق، فالفعل غير المباشر (يُفتضح الفاسق، ويَكذب الفاجر) استُلزِم منه التعريض بابن مرجانة، فهي كانت تقصده، مع أنّها لم تصرّح بذكر اسمه، أو بإلحاق ضمير يحاكي شخصه، وإنّما قالت (هو غيرنا) ولو أشارت إليه لخرج يزيد عن كونه فاجراً فاسقاً، ولكنّها استعملت الضمير (هو) للغائب؛ ليشمل كل من كان خارج دائرة أهل البيت وأصحابهم^، ليدخل في ذلك كل من خالف الكتاب والسنّة، سواء أكان المتلقّي للخطاب حاضراً أم غائباً، والسياق هو الآخر كان يشير إلى أنّ المقصود من كلامها‘ هو ابن مرجانة وأسياده.
2ـ قصدت إعلام عبيدالله بن زياد ومن حضر مجلسه بخطأ تُصوّره نسبة المقصور إلى غير المقصور عليه، ويسمّيه البلاغيّون (قصر القلب)[114].
ثانياً: الالتزام بوحدة الموضوع وكمّيته
1ـ ومما يقارب هذا الفرع ـ احترام قاعدة الكم التي تنصّ على المتحاورين، وتحتمّ عليهما أن لا تكون مشاركتهما أكثر من المطلوب ـ، جواب الإمام الحسين×لرجل من جيش عمر بن سعد، بعد أن قال له: «ألا ترى إلى الفرات يا حسين، كأنّه بطون الحيّات، والله لا تذوقه أو تموت عطشاً. فقال الحسين×: اللهم أمته عطشاً. قال: والله، لقد كان هذا الرجل يقول، أسقوني ماء فيؤتى بماء فيشرب حتى يخرج من فيه، وهو يقول: اسقوني قتلني العطش، فلم يزل حتى مات»[115].
2ـ وكذلك جواب الإمام× على قول رجل منهم يقال[116] له ابن حوزة، حين قال: «أفيكم الحسين، فلم يجبه أحد، فقالها ثلاثاً، فقالوا: نعم، فما حاجتك؟ قال: يا حسين، أبشر بالنار، قال× له: كذبت، بل أقدم على ربٍّ رحيم وشفيع مطاع، فمن أنت؟ قال: ابن حوزة، فرفع الحسين× يديه، فقال: اللهمّ حزه إلى النار، فغضب ابن حوزة، فأقحم فرسه في نهر، فتعلّقت قدمه بالركاب وجالت به الفرس، فسقط عنها، فانقطعت فخده وساقه وقدمه، وبقي جنبه الآخر متعلّقاً بالرّكاب يضرب به كل حجر وشجر حتى مات»[117].
وما يلاحظ في الحوارين هو إعلام الإمام× لكلا الرجلين بمآلهما بلا ذكر للمقدمات، حيث قال للأول: لا تذوق الماء حتى تموت عطشا. وللثاني: أبشر بالنار تردها الساعة. ولو تمعّنت في جواب الإمام× لوجدت أنّ مشاركة الإمام من حيث المعلومات لم تزد عن مشاركة الطرف الآخر في الحوار، فتراه في جوابهما قفز إلى النتيجة بلا ذكر مقدّماتها، من أنّه إمام مفترض الطاعة، وابن بنت رسول الله’، وأنّ جميع أفعاله وأقواله تصبّ في طاعة الله ومرضاته، أي: أنّه التزم بكمّية الموضوع ووحدته[118]، إذ يمكن أن ينتج القصد المستلزم الصريح بناءً على المبادئ الحوارية الأساسية وقوانينها الفرعية التي تستلزم مطابقة المعنى للصيغة الاستلزامية[119] وبيان المعاني الصريحة والمقاصد المستلزمة على وفق الآتي:
المعنى القضوى: الذي أفادته الدلالة الحرفية لعناصر التركيب، وأريد منه الدعاء على الإمام بالويل والثبور.
القصد المستلزم: في الخطاب الأوّل استلزم من قولة الرّجل الإصرار على الجعجعة بالحسين× ـ كما أُمروا ـ حتى القتل، أما في الخطاب الثاني فقولة الرّجل مضافاً للاستلزام الأوّل يُستلزم منها جرأتهم على الله وعلى رسوله التي دفعت بهم إلى مخاطبة أوليائه بهذا الخطاب الذي كان ملؤه التحدّي والتّهكّم الذي أفادته عبارة (أبشر بالنار)[120]، كما في قوله تعالى: (ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ)[121].
وقد جاء جواب الإمام× في كلا الحواريتين على معنيين أيضا:
الأوّل: المعنى القضوي، هو الدلالة الحرفية المعجمية للألفاظ التي جاءت لغرض الدعاء.
الثاني: القصد المستلزم، الذي جاء على أكثر من مستوى:
أ ـ أنجز الإمام× في الحوارية الأولى عبر استعماله للفعل اللّغوي المباشر الذي دلّت عليه صيغة النداء (اللهم)، وصيغة فعل الأمر (افعل) فعلاً لغوياً غير مباشر، استُلزم منه رغبة الإمام× في تحقيق معجزة أمام القوم، علّهم يهتدون، وكذلك بيان صدق الدعوة الحسينية بسرعة استجابة الدعاء. وفي الحوارية الثانية استلزم إبطالاً لادعاء الرّجل، إذ أفادت القوّة الإنجازية الحرفية في إطلاق لفظة (بل)، التي تفيد الإضراب «فإن وقع بعده جملة كان إضراباً عمّا قبلها، إمّا على جهة الإبطال، نحو: (أم يقولون به جنّة بل جاءهم الحق)»[122]؛ بطلان مدّعاه.
ب ـ الوضع النفسي، الذي تمثّل بيقين وثقة الإمام الحسين×بالله وبنفسه، ما جعله يسلّم تسليماً مطلقاً لله، وهو ما عليه (التطابق بين مجريات المقام والحالة النفسية الواقعية)[123] فلجأ في كلا الحوارين إلى الله[124]، وهو ما سيتضح في الوضع المنطقي الآتي:
ج ـ الوضع المنطقي؛ الذي يقضي بأنّ كل ما تكلّم به الإمام×على وفق مجريات الأحداث جاء متوافقاً بين ما قاله×وبين ما تحقّق بالفعل، وهذا هو المقام المنطقي الذي يعني «التطابق بين المقول اللّغوي وما هو واقع بالفعل»[125]، فجاءت الدلالة المعجمية الحرفية للملفوظات التي أطلقها الإمام×مطابقة وموافقة لمقاصده، إذ تجسّد كلامه على سبيل الحقيقة لا المجاز، فقد تحقّق دعاء الإمام×، إذ ورد بحقّ الرجل ـ محاوره الأوّل الذي قال: والله، لا تذوقه أو تموت عطشاً ـ أنّه مات عطشاً «والله، لقد كان يقول اسقوني ماء، فيؤتى بماء، فيشرب حتى يخرج من فيه، وهو يقول،: اسقوني قتلني العطش، فلم يزل حتى مات»[126]. أما في خطابه مع الرجل الآخر، فقد ترجم خطاب الإمام ما يؤمن به ×ويعتقده؛ إذ من غير المنطقي، أن يقوم مصلح مثل الإمام×، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون مصداقاً وترجماناً ومنفّذاً لقوله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)[127]، ومع ذلك لا يكون راجياً لرحمة ربّه؛ لذا اتّصفت الحوارية بالاتّساق بين قول المرسل وبين الواقع، وبين الذي قيل له كمّاً وكيفاً وملاءمةً وطريقةً[128]، حيث جاءت كمّية الأخبار المطلوبة دون زيادة أو نقصان، وكانت متوافقة مع المقام حقيقيةً يعتقد المتكلّم بصحّتها، مضافاً إلى امتلاكه الدليل على صحّتها وصدقها، وبذلك مثلت المناسبة (الملاءمة) وكل تلك التوافقات التي احترمت القواعد مجتمعة، فاستلزمت تفنيد دعوى المخاطب ـ الذي أراد التهكّم ـ وإبطالها.
ثالثاً: احترام الكم في ضوء وحدة الموضوع، ودقّة المعلومات
1 ـ حوارية مسلم بن عقيل وابن زياد[129]
ـ عبيد الله: إيهٍ يا ابن عقيل، أتيت النّاس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة؛ لتشتتهم وتفرّق كلمتهم، وتحمل بعضهم على بعض؟
ـ مسلم بن عقيل×: كلّا، لست أتيت، ولكنّ أهل المصر (تعريض بعبيد الله) زعموا أنّ أباك قتل خيارهم، وسفك دماءهم، وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل، وندعو إلى حكم الكتاب.
يتجلّى في هذه الحوارية التزام مسلم× باحترام الوحدة الموضوعية بشكل واضح، والتقيّد بمقدار المعلومات ودقّتها، ما أفضى بشكل جليّ وبمعونة السياق المقامي والمناسبة إلى خروج كلامه من ظاهر الإخبار ـبعد أن أدرك قصد ابن زياد الذي ظهر في اتهام مسلم بن عقيل بشقّ عصا المسلمين، وفتنتهم بقوله «وحمل بعضهم على بعض» وفي هذا مجوّز لإقامة الحدّ أو قتله ـ واستلزامه المقاصد من خلال المقابلة بين المعنيين:
1ـ المعنى الحرفي القائم بدلالة الفعل القضوي، وبالدلالة الحرفية للتركيب التي أدّت معنى الإخبار.
2ـ القصد المستلزم وهو كالآتي:
أ ـ الأمر بالعدل والإنصاف بين النّاس، والعمل بمقتضيات حكم القرآن.
ب ـ التعريض بسياسة حكم ابن زياد وأسياده، ما دفع ابن زياد إلى الخروج عن آداب الحوار، متوسّلاً بالمزاعم والأكاذيب بغير دليل أو بيّنة، وهو الفشل الحواري الذي يُمنى به منقوص الحجّة، ليواري هزيمته أمام الآخرين بقوله: «وما أنت وذاك يا فاسق، أوَ لم نعمل فيهم، إذ أنت بالمدينة...».
ج ـ ردّ لكلِّ ما جاء في كلام الخصم من اتهامات وافتراء، حيث جاء الردّ مشحوناً بالردع والزّجر بدلالة الفعل اللّغوي "كلّا"[130] الذي ناسب المقام وطبيعة الاتهامات.
ومما يمكن ملاحظته على المحاورة أنّ الكلمات والعبارات في كلام مسلم بن عقيل× وردّ ابن مرجانة، موجزة ودالّة على غرض كل منهما ومقصده من المحاورة، كما تبيّن. ومن هنا تقرّر أنَّ الحوار في خطاب المسيرة في أغلب المواقف ـكما هي الحال في هذا الحوارـقد اتّسم بالإيجاز، فهو في النصوص الحوارية من الضرورة بحال كي لا تنسي كثرةُ الكلام بعضه، بخلاف النصّ السردي قد يمتدّ متتابعاً لبضع صفحات، وهذا راجع إلى طبيعة المتحاورين وقدرتهم على استيعاب الأفكار، فضلاً عن حاكميةالمناسبة، فالمحاور يطرح فكرة، وينتظر الردّ عليها[131]. نعم قد تفارق هذه السّمة النصّ السردي في بعض المقامات، وسياق الحال التي تتطلّب الإطناب في بيان بعض الحقائق المهمّة أو إثباتها، كالمسائل الاعتقادية لبعض أصول الدين مثل التوحيد والنبوّة والإمامة، وبعض المقامات التي تخصّ الأدعية[132].
2 ـ حوارية الإمام الحسين× مع الحصين
«يا أمّة السوء، بئسما خلفتم محمداً في عترته، أما إنّكم لن تقتلوا بعدي عبداً من عباد الله فتهابوا قتله، بل يهون عليكم عند قتلكم إيّاي، وأيم الله إنّي لأرجو أن يكرمني ربي بالشهادة بهوانكم، ثمّ ينتقم لي منكم من حيث لا تشعرون»[133].
ـ الحصين بن مالك: صاح به الحصين بن مالك السكوني، قائلا: يا ابن فاطمة، وبماذا ينتقم لك منّا؟
ـ الإمام× قال: «يُلقى بأسكم بينكم، ويسفك دماءكم، ثمّ يصبّ عليكم العذاب الأليم»[134].
اكتفى الإمام×في جواب الحصين بالنتيجة النهائية، ولم يجعل مساهمته في الحوار تفوق ما هو مطلوب من تقديم الأخبار، وبذلك راعى مضمون السؤال وفحواه؛ إذ ينتج «المعنى المستلزم بناء على المبادئ الحوارية الأساسية وقوانينها الفرعية، التي تستلزم مطابقة المعنى للصيغة اللّغوية المستلزمة»[135] ويمكن أنتُستجلي مقاصد الإمام× على النحو الآتي:
1ـ الجرأة على قتل الحسين مع ما يتمتّع به من المكانة المعنوية، ستفضيـكما أشار الإمام الحسين× ـ إلى إباحة الدماء، خاصّة أنّ كل مقتول منهم بعد الإمام سيكون دون منزلة الإمام الحسين× ودمائه.
2ـ وكنتيجة لقتله× سينالهم الخسران الدنيوي والأخروي، وهذا غاية التمحّل في الخسران.
لم يكتف القوم بدعاء الإمام×، وراح الحصين بن مالك[136] يتهكّم على الحسين×، بقوله: وبماذا ينتقم لك منّا؟ وهنا كلام الحصين خرج إلى معنيين:
أ: المعنى القضوي (الصريح)، وهو ما تؤدّيه عناصر الجملة مجتمعة من معانٍ معجمية، وهو الاستخبار.
ب: القصد المستلزم من كلام الحصين، وهو أننا مصرّون على قتلك، وسفك دمك، فبماذا ينتقم لك منّا؟!، وهنا الاستفهام استلزم التّهكّم، أمّا فحوى جواب الإمام ×، هو أن هؤلاء القوم ختم الله على قلوبهم، بعدما قصرت أبصارهم عن إدراك ما وراء النشأة المادية الدنيوية، فنسوا أنّ الآخرة هي الحياة الباقية، وأنّ الشهيد على الانتقام العاجل غير الآجل الذي سينزل بهم هو الإمام× نفسه، ناهيك عن الخزي والعذاب الأليم في الحياة السرمدية.
أما كلام الإمام×فيمكن أن يُتوصّل إلى مقاصده بالآتي:
أ: المعنى القضوي (الصريح)، وهو ما يؤدّيه الفعل اللّغوي المباشر، والمتمثّل في الدلالة الحرفية للتركيب، وهي:
1ـ الإخبار عمّا سيؤول إليه مصيرهم.
2ـ الإكرام من الله بطلب الشهادة.
3ـ الطلب من الله بالانتقام له منهم من حيث لا يشعرون.
ب: القصد المستلزم: الإمام× أنجز فعلاً لغوياً غير مباشر، نتج من الفعل اللّغوي المباشر بمعونة السياق المقامي ومبدأ التعاون الذي عليه طرفا الحوار؛ إذ يُفترض بالمتلقّي أن يسعى في التفتيش لفهم مقاصد المتكلّم، وهذا الفعل غير المباشر اقتضى الدعاء عليهم، وقد تضمّن الدعاء أمرين: الأوّل كان يخصّ الإمام×، والثاني يخصّ أمّة السوء، فأمّا ما يخصّ الإمام×: فهو إكرام الله له بالشهادة، ومعنى هذا أنّ الإمام اختارها، ولم تُفرض عليه فرضاً[137]، والذي يقوّي هذا الرأي قوله×: «وخِير لي مصرعٌ أنا لاقيه» فهو بناءً على هذا مختار للشهادة وطالب لها. وأمّا ما يخصّ أهل الكوفة، فقد اشتمل على نقطتين:
الأوّلى تضمّنت دعوتين، توخّى الإمام×حصولهما في الدنيا، وهما:
أـ أنْ يُلقي بأسهم بينهم، ومن شأن هذا أن يضعفهم ويكسر شوكتهم، ولعلّ هذا كان سبباً في الدعوة الثانية.
ب ـ سفك دمائهم على يد المختار الثقفي، وهو أمر مكّنه من أن يظفر بالنصر عليهم.
أما الثانية فهي بمنزلة الدعوة عليهم بالخزي والعذاب الأليم، من خلال صبّ العذاب عليهم صبّاً، وهو ما سيتحقّق حتماً في الآخرة.
3ـ حوارية الإمام الحسين× مع قاتليه
«يا إلهي، صبراً على قضائك، ولا معبود سواك، يا غياث المستغيثين»[138]، فتبادر إليه أربعون فارساً يريدون حزّ رأسه الشريف، ويقول عمر بن سعد: «ويلكم، عجّلوا بقتله، فدنا منه شبث بن ربعي، فرمقه الحسين× بعينه، فرمى السيف من يده وولّى هارباً، ويقول: معاذ الله أن ألقى الله بدمك يا حسين، فأقبل إلى شبث سنان بن أنس النخعي، وكان كوسج اللحية، قصيراً أبرص أشبه الخلق بالشمر اللعين، فقال له: لم ما قتلته[139] ثكلتك أمّك؟ قال شبث: يا سنان، إنّه قد فتح عينيه في وجهي، فشبّهتهما بعيني رسول الله’، ثمّ دنا منه سنان، ففتح عينيه في وجهه، فارتعدت يده وسقط السيف منها، وولّى هارباً، فأقبل إلى سنان الشمر اللعين، وقال له: ثكلتك أمّك، مالك رجعت عن قتله؟ فقال: يا شمر، إنّه فتح عينيه في وجهي، فذكرت هيبة أبيه علي بن أبي طالب، ففزعت، فلم أقدر على قتله، فقال له الشمر: إنّك جبان في الحرب، فوالله، ما كان أحد غيري أحقّ منّي بقتل الحسين»[140].
في هذا الخطاب الذي يمكن أن يُعَدّ أنموذجاً لحوارية حصلت في سياق واحد، وأنتجت استلزامين حواريين، أحدهما قائم على احترام قاعدة الكمّ بواسطة التزام المتكلّم بالمقدار اللازم من المعلومات بلا زيادة أو نقصان، والثاني قائم على خرق القاعدة[141].
وتتجلى أهمية استنطاق المنهج التداولي لخطاب المسيرة الحسينية في التعرّف على ظروف تلك الفاجعة الأليمة في يوم العاشر من شهر محرّم الحرام. ذلك اليوم الذي بقي فيه الحسين بن علي× يجود بنفسه ثلاثَ ساعات تحت حرارة الشمس، من كثرة ما أصابه من جراحات في جسده الشريف[142]، وقد أحاط به على رمضاء كربلاء أربعون فارساً مدجّجاً بالسلاح، حينها بدأ الحسين× حواريته مع ربه قائلاً:
ـ الحسين×: «يا إلهي، صبراً على قضائك، ولا معبود سواك، يا غياث المستغيثين»[143].
ـ عمر بن سعد: ويلكم، عجّلوا بقتله[144].
ـ شبث بن ربعي دنا من الحسين× يريد قتله.
ـ الحسين× رمقه بعينيه.
ـ شبث رمى السيف من يده، وقال: معاذ الله أن ألقى الله بدمك يا حسين.
ـ سنان بن أنس النخعي: لمَ لمْ تقتله، ثكلتك أمّك؟
ـ شبث: يا سنان، إنّه قد فتح عينيه، فشبّهتهما بعيني رسول الله’.
ـ سنان دنا من الحسين× يريد قتله.
ـ الحسين×فتح عينيه يريد معرفة قاتله.
ـ سنان ارتعدت يده، وسقط السيف، وولّى هارباً.
ـ الشمر: ثكلتك أمّك، مالك رجعت عن قتله؟
ـ سنان: فتح عينيه، فتذكّرت هيبة أبيه علي بن أبي طالب، ففزعت.
ـ الشمر: إنّك جبان في الحرب.
الإمام الحسين×كان يناجي ربّه في خطابه المقتضب العالي المضامين، وفي ظلّ الظرف والسياق الحالي الذي تهيّأ للإمام، والذي أفضى إلى مراعات مقدار المعلومات اللازمة للحوار، في ضوء قاعدة الكمّ ومراعاة المقام.
أمّا المسوّغات التي جعلت الإمام× يتوخّى الالتزام في مقدار الكمّ، فهي:
1ـ الوضع النفسي الذي هو عليه بسبب كثرة الجراحات، فضلاً عن العطش.
2ـ قتل كل أصحابه وأهل بيته، مما يعني أنّه بقي وحيداً فريداً مع كثرة الأعداء.
3ـ قطع رجائه من كل أحد سوى الله.
4ـ قلّة الناصر.
كل هذه المسوّغات مجتمعة ـالتي وفّرها السياقـكانت سبباً في هذا الكمّ من حيث دقّة المعلومات الواردة فيه ومقدارها، والتي استلزمت بطبيعة الحال مقصدية الدعاء، والتي تركّزت بثلاثة طلبات:
أولاً: التوجّه إلى الله عن طريق الفعل اللّغوي المباشر بالاستعانة وطلب الصبر الذي دلّت عليه القرينة، وهو المصدر النائب عن فعل الأمر، ومعناه القضوي في دلالته الحرفية الذي خرج إلى طلب الصبر، ولما كان الأمر من الداني إلى العالي، استلزم ذلك فعلاً لغوياً غير مباشر، تمثّل في مقصديّة الدعاء.
ثانياً: نفي العبودية لغير الله تعالى، وهنا الجملة الخبرية التي تشكّلت بالفعل اللّغوي المباشر، الذي دلّت عليه القرينة (لا النافية للجنس واسمها) الذي دلّ على قوّة إنجازية مباشرة وهي الإخبار، وأنجز فعلاً لغوياً غير مباشر، استلزم منه التنزيه لله الواحد الأحد، من قبل الإمام×.
ثالثاً: الاستغاثة بالله من هؤلاء القوم، لأنّه ليس للامام × سوى الدعاء والاستغاثة بمعبوده، وعلمه بحاله يغني عن الإلحاح وكثرة الضراعة له جلّ شأنه، وهنا الإمام× لم يطلب النصر، بل ركّز على الأشياء الممكنة التي يمكن أن تتحقق، وأمّا غيرها فلم يطلبها؛ لأنّ طلبها يكون لغواً، وحاشاه.
الجزء الثاني من الحوارية لا يعني البحث فيه قصد الخصم بقدر ما يعني مقاصد الإمام×الأُخر، وقد يُعتمد على دور حركات الجسم في المواقف الحوارية، ففي هذا الجزء تبيّن أنّ الإمام× اكتفى بحركة واحدة قد أنجزت فعلاً لغوياً غير مباشر، ومن ثمّ قوّة إنجازية جعلت الخصم أو العدو ـ وهما كلٌّ من شبث وسنان ـ يفزعان ويفرّان ويحجمان عن قتله، فما هي تلك الحركة؟ وما أثرها في تطور إجرائية الحوار؟
يقول نبيل علي: «إنّ شفاهية الحوار المباشر تزخر بالانفعالات، وتؤازرها عادة ألوان متعددة ومتضافرة من أفعال الكلام...، مثل حركات اليد والعينيين وخلجات الشفاه وتغيير ملامح الوجه وأوضاع البدن»[145].
وعليه؛ تكون كل هذه الحالات قد توافرت في هذا الحوار، فقد أدّت حركة عيني الإمام× ما تستطيع أن تؤدّيه الكلمة وزيادة، فـاللغة في حالة الكتابة تقوم بكل الوظائف، وتجمع كل عناصر النصّ، بعكسها في حالة الحوار، فإنّ عنصراً واحداً كحركة اليد أو نظرة العين بمعونة عناصر متنوّعة، قد تقول مالا تقوله اللغة[146]، وقديماً أشار الجاحظ إلى أثر الإشارة الجسميّة في التواصل الحواري بقوله: «فأمّا الإشارة فباليد وبالرأس وبالعين والحاجب والمنكب، إذا تباعد الشخصان بالثوب وبالسيف...، والإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغني عن الخط»[147]، وهنا يتراءى سؤال مهم: ما الذي أنجزته نظرة الإمام×من فعل غير مباشر، جعل شبث بن ربعي يردّ على الإمام× بقوله: معاذ الله أن ألقى الله بدمك يا حسين؟
وفي الجواب نقول: إذا جاز عدّ الفعل اللّغوي المباشر لنظرة الإمام×والذي دلّت عليه حركة الجفنين هو الرؤية الباصرة، فإنّ هذا الفعل الإشاري قد استلزم فعلاً لغوياً غير مباشر، وهو عتاب النبي’ لشبث، والذي يرشّح هذا المعنى قول شبث نفسه لسنان حينما استنكر عليه الأخير إحجامه عن قتل الإمام×: إنّي شبّهتهما بعيني رسول الله، ما يستلزم أنّه قد رأى النبي’، وأنّ هاتين العينين مع ما تعرّضتا له من أذى، إلّا أنّهما بلّغتا عتاب النبي’ واستنكاره لفعلهم الشنيع، في حين نجد أنّ الفعل الإشاري الأوّل نفسه الذي صدر من الإمام× مع شبث يستلزم منه فعلاً لغوياً آخر مع سنان، خرج إلى مقصديّة التهديد والزجر، مما جعله يرتعد خوفاً من مهابة الإمام علي×، بدليل تبريره للشمر حينما استنكر عليه جُبنه، قال: تذكّرت هيبة أبيه علي بن أبي طالب×، ولله درّ الشاعر:
|
ولا سيما أبو حسن علي له في الحرب مرتبة تهاب[148]. |
لا شكّ أنّ سنان كان ممن شهد صولات أبي الحسن×التي كان من شأنها بثّ الرعب والخوف في فرائصه.
إنّ خرق القاعدة يقضي الإخلال بكمّية المعلومات اللازمة لتبليغ القصد للمتلقّي، بما يضمن نجاح التواصل وتحقيق الغرض، ويحصل الخلل إمّا بقلّة المعلومات الواجب توافرها، أو وفرتها بأن تكون أكثر مما يتطلّبه، حيث يلحظ ذلك من خلال لحاظين؛ الأوّل:
الاعتبار الخطابي في اللغة المستعملة، وهو لا يتحدّد في كمّ معيّن من الألفاظ أو التراكيب.
والثاني: يتجلّى في درجة الوضوح والشفافية، فكلّما تردّد الحوار بين هذين القطبين تأثّرت المادة اللّغوية، ومن ثمّ ينعكس على إيصال القصد[149].
وحاصل الخرق موكول إلى المتكلّم، فهو محدّد بظروف مقامية أو تحاورية، تجعله يسلك نمطاً غير متعارف عليه لهذه القاعدة، مع ترك شفرة تُعِين المتلقّي على سبر أغوار النص في ظل الظروف التي تكتنف الحوار، والتي جعلت الإمام× في خطاباته يسلك هذا الأسلوب[150]. والخرق في هذه القاعد يأتي على مستويين:
المستوى الأوّل: الخرق بتقديم معلومات أكثر مما يتطلّبه المقام
ومما يقارب خرق النوع الأوّل من قاعدة الكم، ما جاء من حوارية دارت بين الحسين× والشمر، نقلها القندوزي، قائلاً: «ثمّ أنّه ركب على صدره الشريف، ووضع السيف في نحره، وهمّ أن يذبحه، ففتح عينيه في وجهه، فقال له الحسين: يا ويلك، من أنت فقد ارتقيت مرتقى عظيماً؟ فقال له الشمر: الذي ركبك هو الشمر بن ذي الجوشن الضبابي، فقال له الحسين: أتعرفني يا شمر؟ قال: نعم، أنت الحسين بن علي، وجدّك رسول الله، وأمّك فاطمة الزهراء، وأخوك الحسن، فقال: ويلك، فإذا علمت ذلك فلم تقتلني؟ قال: أريد بذلك الجائزة من يزيد، فقال له: يا ويلك، أيّما أحبّ إليك، الجائزة من يزيد أم شفاعة جدّي رسول الله’؟ فقال الشمر الملعون: دانق من جائزة يزيد أحبّ إلى الشمر من شفاعة جدّك، فقال له الحسين (رضي الله عنه وبلّغه الله إلى غاية بركاته ومنتهى رضوانه): سألتك بالله أن تكشف لي بطنك، فكشف بطنه، فإذا بطنه أبرص كبطن الكلاب، وشعره كشعر الخنازير، فقال الحسين×: الله أكبر، لقد صدق جدّي’ في قوله لأبي: يا علي، إنّ ولدك الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء، يقتله رجل أبرص أشبه بالكلاب والخنازير، فقال الشمر اللعين: تشبّهني بالكلاب والخنازير، فوالله لأذبحنّك من قفاك، ثمّ إنّ الملعون قطع الرأس الشريف المبارك، وكلّما قطع منه عضواً يقول×: يا جدّاه، يا محمداه، يا أبا القاسماه، ويا أبتاه، يا عليّاه، يا أمّاه، يا فاطماه، أقتل مظلوماً، وأذبح عطشاناً، وأموت غريباً، فلمّا اجتزّه وعلاه على القناة، كبّر وكبّر العسكر ثلاث تكبيرات...، وكان يوم قتله يوم الجمعة عاشر المحرّم الحرام سنة إحدى وستّين»[151].
بدأ الحوار:
ـ الحسين×: يا ويلك، من أنت فقد ارتقيت مرتقًى عظيماً؟
ـ الشمر: الذي ركبك هو الشمر بن ذي الجوشن الضبابي.
ـ الحسين×: أتعرفني يا شمر؟
ـ الشمر: نعم، أنت الحسين بن علي، وجدّك رسول الله، وأمّك فاطمة الزهراء، وأخوك الحسن.
ـ الحسين×: ويلك، فإذا علمت ذلك فلم تقتلني؟
ـ الشمر: أريد بذلك الجائزَة مِن يزيد.
ـ الحسين×: يا ويلك، أيّما أحبّ إليك، الجائزة من يزيد أم شفاعة جدّي رسول الله’؟!!
ـ الشمر: دانق من جائزة يزيد أحبّ إلى الشمر من شفاعة جدّك.
ـ الحسين×: سألتك بالله أن تكشف لي بطنك.
ـ الشمر، فكشف بطنه فإذا بطنه أبرص كبطن الكلاب، وشعره كشعر الخنازير.
ـ الحسين×: الله أكبر، لقد صدق جدّي’ في قوله لأبي: يا علي، إنّ ولدك الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء، يقتله رجل أبرص أشبه بالكلاب والخنازير.
ـ الشمر: تشبّهني بالكلاب والخنازير، فوالله لأذبحنّك من قفاك.
لا شكّ في أنّ أيّة عملية حوارية لا بدّ لها من موجّه أو مدير، يوجّه الأسئلة ويدير محاورالعملية التواصليّة ومفاصلها، وفي خطاب المسيرة الحسينية كان دور روّاد المسيرة واضحاً في إدارة دفّة الحوار، بغية تحقيق القصد وجني النتائج التي كانت جميعها إلى جانب أصحاب المسيرة الحسينية، وهذا ما تحقّق بالفعل.
ويظهر دور الإمام× في إدارة هذا الحوار وغيره جليّاً، إذ وجّه المخاطب بمعيّة المتكلّم إلى تقديم معلومات وفيرة تفوق منطوق السؤال، وقد استطاع الإمام× بهذا الخرق وبمستوياته البنائية والتداوليةـالذي ينطبق عليهوسيلتان من وسائل تحليل الخطاب، هما: مبدأ التعاون بقواعده التي هي موضوع الدراسة، ومبدأ التأدّب (اللايكوفي) ـ أن يوضّح فكرة واحدة (بيان مظلوميتهم).
إنّ ناتج هذا الخرق متحصّل من الظروف المقامية المضطربة التي اكتنفت الحوار، من خلال توفر مسوّغات ـ مرتكزة في ذهن المتكلّم ـ للخرق، وقد توفّر منها:
1ـ التجمّع الكبير من الجنود الذين تحلقوا[152] حوله، فقد ذُكر: «فتبادر إليه أربعون فارساً، يريدون حزَّ رأسه الشريف المكرّم المبارك»[153].
2ـ رغبة ابن سعد في إنهاء المهمة البشعة بحزّ رأس الإمام الحسين× بقوله: «ويلكم، عجّلوا بقتله».
3ـ فزع وخوف جميع الفرسان من الإقدام على انتهاك جسد الإمام الحسين×، مع ما كانوا يتمتّعون به من وضاعة القيم والصفات، فتقدّم له أشرّ الخلق، قبل الشمر وأشبههم به، وهم: شبث بن ربعي، وسنان بن أنس النخعي، وكان كوسج اللحية قصيراً أبرصاً أشبه الخلق بالشمر اللعين[154]، إلّا أنّهم هربوا خوفاً ورهبة من نظرات الحسين× حينما رمقهم بعينيه، فقد ذكّرهم بشجاعة أبيه، وكلّهم قد خبروا شجاعته. فاستثمر الإمام هذه الفرص، بل جميع الفرص المتوافرة لبيان أحقّيتهم بالإمامة، ولإظهار مظلوميّتهم من أمّة جدّهم’، لذا استنطق المخاطَب وجعله يخرق الكم، ويقدّم أخباراً تفوق سؤال الإمام×، والمخاطَب بدوره استغلّ الخرق لبثّ قصده، حيث جاء بعض قصده متماشياً مع قصد الإمام× إلى حدٍ ما، فقد جاء الحوار على ثلاثة محاور:
المحور الأوّل: محور التعارف الصوري الشكلي، فالإمام× أعرف النّاس بقاتله
في هذا المحور سنتعرّف على أهم الوسائل اللّسانية التي وظّفها الإمام× لبلوغ مقاصده، منها ما دلّت عليه القرائن اللفظية؛ وهي (النداء، والجمل الخبرية، والتعريف بالاسم الموصول)، ومنها ما دلَّ عليه السياق كمبدأ التعاون، ومبدأ التأدب.
ـ الحسين×: يا ويلك، من أنت فقد ارتقيت مرتقىً عظيماً؟
وهذا ما سيتّضح في المحاور أدناه:
بوصف النداء فعلاً كلامياً فإنّه يوّلد أثرا خاصا عند المخاطب؛ لأنه ليس مقصوداً لذاته ولا يقتصر على الفعل القولي فقط؛ بل يحمل قوّة إنجازية وتأثيراً في المخاطب[155]، فقد عرّفه النحاة لغةً: بأنّه الدعاء بأيِّ لفظٍ كان[156]، وعُرِّفَ اصطلاحاً: بأنّه طلب الإقبال بحرف ناب مناب أدعو، ملفوظاً به أو مقدّراً، والمراد بالإقبال يشمل الحقيقي والمجازي، المقصود منه الإجابة، كما في قول الداعي: يا الله ولا يَرُد، أو قوله: يا زيد لا تُقبل؛ لأنّ (يا) لطلب الإقبال والتنبيه والالتفات لسماع النهي، فالنهي عن الإقبال بعد التوجّه[157]، وعلى هذا يمكن استنتاج أمور عدّة تؤسّس قصد المتكلّم:
1ـ إنّ الدعاء أو طلب الإقبال يستدعي طرفين، أحدهما داع والآخر مدعو، وفي هذا المحور هما: (الإمام الحسين×.. )، و(الشمر).
2ـ النداء ما هو إلّا خطابٌ موجّهٌ من متكلّم إلى مخاطب، يريد إقباله عليه والتوجّه إليه ليحاوره ويكلّمه؛ «لأنّ الأعمال المضمّنة في القول تتطلّب مشاركة المخاطب، فنحن لا ننشئ استفهاماً، أو إثباتاً، أو أمراً، أو وعداً...، إلّا ونحن نتوجّه إلى مخاطب معيّن»[158]، يقول ابن جنّي: «إذا أقبل عليه، وأصغى إليه، اندفع يحدّثه أو يأمره أو ينهاه»[159]، فالنداء ليس مقصوداً لذاته، بل ينصرف قصد المتكلّم إلى تنبيه المخاطب ليصغي إلى ما يجيء بعده من الكلام المنادى له[160]، ومن هنا يمكن أن يُستدلّ على أنّ المنادى هو الشمر شخصياً من قرينتين. قرينة بنيوية وأخرى حالية. أمّا القرينة البنيوية فقد دلّت عليها صيغة النداء (يا ويلك)؛ إذ اشترط النّحاة أن يكون المنادى متميّز الماهية، وإن لَم يكن معلوم الذات، فلا معنى لنحو: يا شيء، ويا موجود، ويا ويل، إلّا أن يكنّى بمثلهما عن أنّ المخاطب ما فيه شيء مما يكون في العقلاء، إلّا أنّه يقع عليه اسم الشيء والموجود، وهذا مجاز وكلامنا في الحقيقة[161]، فالرضي يشترط أن يكون متميّز الماهية حتى يتوافر عنصر القصد، ولذا لا يجوز النداء بمثل (يا ويلك) لعدم توفّر القصد على الحقيقة، وأمّا القرينة الحالية، فدلّ عليها اعتلاء الشمر صدر الحسين×. وعليه يستلزم الأمر قصدين:
القصد الأوّل: التقريع والتوبيخ، فالمتكلّم كنّى عن الشمر، بأنّه ليس فيه شيء مما يكون للعقلاء، وبالتالي جرّده عن صفة العقل.
القصد الثاني: الإمام× قصد إقبال الشمر عليه والتفاته إليه؛ كي يحذّره من عذاب جهنم، وعن عبد الله بن مسعود: ويل وادي في جهنم من قيح[162]. والذي يقوّي المعنيين ويرشّحهما النقطة الآتية (ب).
الذي يرشّح التقريع والتوبيخ اللذين خرج لهما النداء، هو الفعل القضوي، الذي أنجز فعلين لغويين، الأوّل تمثّل بجملة القول التي يمكن الاستدلال عليها من القرينة البنيوية وهي (قد+ الفعل المضارع) والتي أنجزت فعلاً لغوياً مباشراً، دلّ عليه المعنى الحرفي للتركيب(قد ارتقيت مرتقى) وهو الإخبار، إلّا أنّ المقام يستلزم من الفعل اللّغوي المباشر فعلاً لغوياً غير مباشر، وهو الأمر بالنزول من هذا المرتقى العظيم، أي أن المقام المقصود للإمام×هو مقام الإمامة.
ج ـ مقصديّة التعريف بالاسم الموصول
إنّ سلّم"المعارف" عند أغلب النّحاة يتصدّره التعريف بالأقوى؛ (فالاسم العلم، هو أقوى المعارف، تليه المبهمات: الاسم الموصول، واسم الإشارة، الضمير)[163]، والذي يساعد المتكلّم في أن يلجأ إلى هذا التعريف هو مقام التلفّظ، أي: عند ما يكون نقص في معلومات المخاطب عن المسند إليه، ما خلا الصّلة، مثل: الذين قاتلوا مع الحسين× علماء صالحون[164]. وجاء في جواب سؤال الإمام، قول الشمر: الذي ركبك هو الشمر بن ذي الجوشن الضبابي.
ففي محور التعارف الصوري خرق الشمر قاعدة الكم مرّتين:
ـ الخرق الأوّل: الشمر خرق قاعدة الكم، وكان لازم الجواب وما يناسب المقام أن يقول: الشمر أو غاية ما في الأمر، (الذي ركب الشمر) فما المسوّغ لهذا الخرق في وفرة كمّية المعلومات التي قالها في ظرف مضطرب وحرج زمانياً ومكانياً ومقامياً، إذ المقام هو ارتكاب أبشع جريمة في الوجود؟ بل في تاريخ الإنسانية، وهذه المعلومات تمثّلت بذكر اسمه كاملاً ولقبه، ولها جملة من المسوّغات:
1ـ حضور الجمع الغفير من العسكر الذي بلغ أربعين فارساً.
2ـ خوف بعض الأسماء اللامعة في معسكر ابن سعد وإحجامهم عن الإقدام من قبل شبث بن ربعي، وسنان بن أنس النخعي، وعدم تمكّنهم.
3ـ رغبة الشمر في شهادة عمر بن سعد له أمام يزيد للحصول على الجائزة.
4ـ الافتخار بنفسه.
5ـ تعريف نفسه لمن لا يعرفه.
كل هذه المسوّغات بمعونة المقام دفعت الشمر للتعريف بنفسه على غير العادة[165]، إذ بدأ بالاسم الموصل مع صلته، وهو فعل كلامي، ليس مقصوداً بذاته، ليُنجز فعلين لغويين، أحدهما مباشر والذي يُستدل عليه من خلال القرينة البنيوية المتمثّلة (بالاسم الموصول+ جملة الصلة)، ومعناه القضوي دلالته الحرفية وهو التعريف، أما الفعل غير المباشر الذي يستلزم من المباشر فيحتمل قصدين:
1ـ أن يجعله ذريعة لتحقيق الخبر، أي: تقريره وتثبيته في ذهن المستمع أو المخاطب، حتى كأنّ الإيماء المستلزَم برهان عليه.
2ـ يستلزم منه تعظيم غير الخبر، كما في قوله تعالى: (ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)[166].
فهنا قصد أنّ الخبر المبني على الموصول وصلته مما ينبئ عن الخيبة والخسران وتعظيم الشأن لشعيب[167]. والذي يؤيّد هذا المعنى قول الإمام الحسين× ارتقيت مرتقى عظيماً. فالمرتقى هو جسد الإمام×، أو ما هو أبعد من ذلك؛ أي ارتقى منهجاً وديناً ونبوةً وإمامةً وقرآناً ناطقاً، فالتعظيم لهذا كلّه لا للشمر كما قد يُتوهّم.
ـ الخرق الثاني: تمثّل بتقديم معلومات زائدة في جوابه عن سؤال الحسين× الثاني: هل تعرفني؟، ولازم هذا السؤال، هو نعم أعرفك أو لا أعرفك. بلا لجوء إلى التفصيل (أنت الحسين بن علي بن فاطمة الزهراء ابن رسول الله أخوك الإمام الحسن) الذي لا يقتضيه المقام ولا الكم، فأيّ صلافةٍ وأيّ جرأة يمتلكها الشمر؟! وكأنّه أي: الشمر، أراد أن يخبر الإمام× بأنّي أعرفك تمام المعرفة.
المحور الثاني: محور التحقق من فعل الشمر
قال الإمام الحسين×: ويلك، فإذا علمت ذلك فلمَ تقتلني؟
قال الشمر: أريد بذلك الجائزة من يزيد.
فقال له الإمام الحسين×: يا ويلك، أيّهما أحبّ إليك، الجائزة من يزيد أم شفاعة جدّي رسول الله’؟
فقال الشمر: دانق من جائزة يزيد أحبّ إلى الشمر من شفاعة جدّك.
ويمكن ذكرُ مسوّغٍ آخر مهم في هذا المحور يضاف لما سبق: وهو الرحمة والعطف اللّذَان كانا حقيقة جوهر الأئمة التكويني، فهم فيض الرحمة الإلهية.
أمّا قصد الإمام× الذي سنتعرّف عليه بعد الوقوف على مفاصل الخرق، في ضوء مبادئ وآليات تحليل الخطاب (مبدأ التعاون، ومبدأ التأدب) فيتمثّل في حصول خرقٍ في قاعدة الكم، بزيادة المعلومات التي استعملها الإمام×، والحال أنّ الردّ على هكذا عدوّ لِمَن هم في سياق حال شبيه بهذا السياق يكون هو الدعاء، لكن المتمعّن يكشف أنّ الحسين×ومن أجل بلوغ تمام قصده، مع شدّة الوضع الذي يكشفه الدعاء في مقدّمة الحوارية، حيث احترم فيه الإمام الحسين× قاعدة المناسبة، أما خرق قاعدة الكم على الفرع الثاني فهو تقديم أقلّ عدد من المعلومات على وفق مقتضى المقام بقوله: «يا إلهي، صبراً على قضائك، ولا معبود سواك، يا غياث المستغيثين»[168] وإقامة الحجّة على المخاطب.
ففي بداية المحور الثاني، مع أنّ الإمام×قد دعا عليه بالويل، أي: ويل لك، إلّا أنّ نفسَ الرحمة التي جبل عليها الإمام ـمنذ أن خرج إلى العراق، بل منذ ولادته وحتى آخر لحظات حياته ـ بدت متجسّدة في أفعاله وأقواله، فعلى الرغم مما لحقه من أذى، وقتل لأهل بيته وأصحابه، وبعدما تبين له شدة عناد الشمر وإصراره من خلال تعريفه بالإمام× وعنوانه واسمه ومكانته من رسول الله’، إلّا أنّه قد منحه فرصة التراجع عن سفك دمه من خلال التشكيك في حقيقة فعله عبر أسلوب التوجيه المركّب. والتوجيه المركّب أعني به ما جاء مركّباً من أسلوبي الشرط والاستفهام، ولعلّ وراء أساليب التوجيه هذه أسباباً تدفع المتكلّم إلى تعديل قوّته الإنجازية في التعبير عن فعله الكلامي[169]:
1ـ التعديل من أجل نقل المعنى (القصد) المرتبط بسلوك المتكلّم وتصرّفاته تجاه القضية التي يُعبّر عنها Modal Meaning.
2ـ التعديل من أجل التعبير عن معنى تأثيري Affective Meaning أو عن سلوك المتكلّم إزاء المخاطب في سياق المنطوق[170].
وفي ضوء مسوّغات خرق الخطاب في أعلاه تتبيّن مقاصد الإمام× على النحو الآتي:
1ـ الإمام×أراد أن يبيّن للمتلقّي أنّه تعرّف على عزمه وإصراره لارتكاب هذا الأمر الجلل، عن طريق القوّة الإنجازية لأسلوبي الشرط والاستفهام، فالفعل اللّغوي المباشر والذي دلّت عليه القرينة (أداة الشرط "إذا" فعل الشرط) أعطى قوّة إنجازية حرفية من تعلّق حصول الجواب بحصول الشرط، في حين أنّه أفضى إلى قوّة إنجازية وقصدٍ غير مباشر يستلزم منه، التماس العذر ـ عبر قاعدة التعفّف ـ إن كان جاهلاً أو مغرّراً به، وهذا قريب جدّاً من مفهوم مخالفة الشرط عند الأصوليين.
أمّا الفعل اللّغوي المباشر الآخر فهو الذي دلّت عليه القرينة اللفظية (ما الاستفهام مع صيغة الفعل المضارع «تقتلني») وقوّته الإنجازية المباشرة هي دلالة التركيب الحرفية التي اقتضت معرفة واستخباراً عما يجهله المتكلّم ـ بشكل عام ـ ما خلا سؤال الإمام×غير الكاشف عن جهل، بل عن علم ودراية بعواقب مصيره المحتوم، والذي أفضى إلى استلزام قوّة إنجازية سياقية أخرى تراءى من خلالها قصد الإنكار وإبداء الاستغراب من هكذا فعل، لاسيما بعد ما أكّد الشمر للإمام حقيقة ما يقدم عليه.
2ـ قصد التلويح للشمر بعد أن شكّك بفعله إلى تخييره بين مصيرين وطريقين:
أ ـ طريق الهلكة الذي يقوده لجهنم باتباعه لحكومة الجور والظلم وسلطانها (المتمثّلة بيزيد)، التي مصيرها الزوال.
ب ـ طريق النجاة باتباع الحقّ والركوب في قارب النجاة، فقد ورد في الحديث عن النبي’ أنَّ «الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة»[171].
3ـ من المقاصد التي أراد الإمام× إيصالها إلى المتلقّي التأكيد على شرعيّته في ما يقول ويفعل، وعلى انتسابه إلى رسول الله’ بقوله (جدّي)، ولو لم يُرد ذلك لاكتفى بقوله رسول الله’، ولم يقدّم زيادة في المعلومات، إلّا بقصد إقامة الحجّة على العدو من أنّهم خرجوا على الخليفة الشرعي، وكذلك نقضهم للعهود والمواثيق، بعد أن قاموا بدعوته لإمامتهم، وقد سبق هذا التكرار لتأكيد إقامة الحجّة ورفع التضليل عنهم، لعلّهم تحت وطأة التضليل المغرر.
فتعساً لهاتيك القلوب التي تعيش تيهاناً وضلالاً وريناً، تدفع مثل الشمر أن يردّ على الإمام×بقوله: دانق من جائزة يزيد أحبّ إليّ من شفاعة جدّك. مما يكشف عن الخرق الحاصل بكمّية المعلومات ومقدارها، التي قدّمها الشمر، والتي قصد منها بيان بغضه للنبي وآل النبي’، بعد ما سمعه من طول حوار بينه وبين الإمام الحسين× في ظلّ ظرف حرج، وكذلك لبيان موالاته للطاغية يزيد أمام هذا الحشد وقائدهم. فالدانق: وهو المهزول الساقط من الأشياء[172]، أو هو لفظ كناية عن الشحّ والبخل أو القلّة في الشيء[173]، لاحظ أنّ الشمر قد تعطّلت عنده وعند غيره من أجلاف العرب كل مقاييس التفاضل وقول الفضيلة، فهم ـ بحق ـ كانوا مصداقاً لقوله تعالى: (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)[174].
المحور الثالث: محور الكشف عن صفات الفاعل (الشمر)
ـ فقال له الحسين×: «سألتك بالله أن تكشف لي بطنك».
ـ الشمر: فكشف بطنه، فإذا بطنه أبرص كبطن الكلاب، وشعره كشعر الخنازير.
ـ فقال الحسين×: «الله أكبر، لقد صدق جدي’ في قوله لأبي: يا علي، إنّ ولدك الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء، يقتله رجل أبرص أشبه بالكلاب والخنازير».
ـ فقال الشمر: تشبّهني بالكلاب والخنازير، فوالله لأذبحنّك من قفاك.
بعد أن استنفد الإمام× كل وسائل الدعوة والهداية مع أهل الكوفة وأقلّ الخليقة قدراً، لجأ في هذا المحور الأخير من المحاورة الذي به ختم المسيرة والرسالة الخالدة؛ التي غذّاها بالأجساد الزاكية من أصحابه وأهل بيته، وبجسده ودمه الطاهرين، إلى بيان صفات قاتله التي عهدها إليه جدّه رسول الله’، ذلك الجد الذي لا ينطق عن الهوى. حيث نرصد للمسوّغات السابقة نفسها التي قادت إلى هذا الخرق في كم المعلومات ومقدارها مقاصد، وهي كالآتي:
1ـ أراد أن يخبرهم بأنّه لا يجرأ أحد على هذه الفعلة إلّا من تمتّع بهذه الصفات، في ظل هكذا ظروف داخلية وخارجية أحاطت بالمسيرة وأهلها.
2ـ في المقطع الثاني من الحوارية قصد الإمام× إلى ضخِّ كمّيةٍ كبيرة من المعلومات التي جاءت مشحونة بقوّة إنجازية تناوبت عليها بعض الأدوات والأفعال اللّغوية، التي دلّت عليها القرائن البنيوية متراوحة بين الجملة الخبرية (الله أكبر) و(لام التوكيد) و(قد) التي تفيد التحقيق إذا دخلت على الفعل الماضي. مضافا إليها الدلالة المعجمية للفعل الماضي (صدق) ولفظة (جدّي) و(أبي) الذي جعله بمثابة الشاهد، والفعل اللّغوي المباشر الذي دلّت عليه القرينة البنيوية لصيغة المبني للمجهول (يُقْتل) الذي خرج عن دلالته الحرفية إلى معنى مستلزم؛ وهو التأكيد على عملية القتل دون التأكيد على تسمية القاتل، وذلك من خلال النكرة التي خُصّصت بالصفات التي لا تنطبق على غير الشمر بن ذي الجوشن الضبابي.
لا شكّ في أنّ هذا القاتل وهذه الصفات لم تكن وليدة ظروف طبيعية دعت النبي’ أن يعرِّفه للإمام علي × قبل أكثر من خمسين عاماً على حصول الجريمة النكراء، وإنّما كانت هناك أرضية خصبة لاحتضان نطفة السوء على مدار هذه السنين عبر الأصلاب الخاوية والأرحام المنجّسة، لكي تُدّخر لقطع ريحانة رسول الله’.
ويطالع الباحث نموذجاً آخر لخرق قاعدة الكم، توضّحه حوارية الإمام×حينما طلب قليلاً من الماء، فهبّ أحد الجند لجوابه قائلاً: « والله، لا تذوقه حتى ترد الحامية، فتشرب من حميمها، فقال×: بل أرد على جدّي رسول الله’، وأسكن معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشرب من ماء غير آسن، وأشكو إليه ما ارتكبتم منّي وفعلتم بي، فغضبوا بأجمعهم، حتى كأنّ الرحمة سلبت من قلوبهم»[175].
الحسين×: استسقى الماء.
أحد الجند: والله، لا تذوقه حتى ترد الحامية، فتشرب من حميمها.
الحسين×: «بل أرد على جدّي رسول الله’، وأسكن معه في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأشرب من ماء غير آسن، وأشكو إليه ما ارتكبتم منّي وفعلتم بي، فغضبوا بأجمعهم، حتى كأنّ الرحمة سلبت من قلوبهم» فمقتضى احترام القاعدة هو قول أحد الجند للإمام: (لا تذوقه) وحسب، ولكنّه خرقه بالتجاوز على الإمام× بِعدِّه من أهل النار، فلفظ الحامية فيه تلويح، بل هو أحد أسماء النار، مما جعل الإمام× يلجأ ـ أيضاً ـ لخرق في تقديم سيلٍ من المعلومات، ومقتضى الحال أن يردّه بقوله: «كذبت إنّما غيرنا من يرد الحامية وهم الظالمون»، لكنَّ الإمام× قصد من تقديم هذا الكم الهائل من المعلومات ما يلي:
ـ قرب الإمام×المادّي والمعنوي ومنزلته من رسول الله’، عبر تكراره لفظ جدّي، ويكفي أن يقول رسول الله’، ومن المعلوم عند جميع المسلمين أنّ الحسين× ابن بنت رسول الله’.
ـ التأكيد على مقامه وإمامته، فهو الوريث الشرعي لجدّه وأبيه.
ـ إشارة الإمام×إلى حيثية أخرى تتعلق بذلك
المقام العلي، وتتناسب مع سياق الحوارية؛ ألا وهي الاستقرار والسكنى بمعية جدّه في
سكناه الأبدية؛ في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد جاء هذا التفصيل لدفع التوهّم عن
أذهان السامعين بعدما سمعوا مقالة الجندي، حيث استلزم تكراره × لظروف المكان بطلان دعوى المدّعي
عليه. ولم يكتف بذلك، بل راح يقدّم المزيد من التأكيدات لنفس القصد أعلاه، بقوله: (وأشرب
من ماء غير آسن)، بل سأقدم بين يدي جدّي شكوى ضدّكم «وأشكو إليه ما ارتكبتم منّي وفعلتم بي»،
وهذا ما جعلهم يغضبون
ـفغضبوا
بأجمعهم حتى كأنّ الرحمة سلبت من قلوبهمـمنه×
لعلمهم بصدقه، ولعلمهم بمكانة رسول الله’ وبرّ الله له ولأهل بيته، وأن مصيرهم
سيكون النار لا محالة، لكنّهم يعيشون حالة من التيه والضلال لا يمكن وصفها بأيّ شكل
من الأشكال.
وممّا يقارب الخرق في الكمّ المعلوماتي هو ما دار من حوار بين الإمام السجاد× وبين الشيخ الشامي؛ ونصّه كالآتي:
«جاء شيخ فدنا من نساء الحسين× وعياله، وقال: الحمد لله الذي أهلككم وقتلكم، وأراح البلاد من رجالكم، وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال له علي بن الحسين×: يا شيخ، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل عرفت هذه الآية (ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) ؟ قال: قد قرأت ذلك. فقال له علي: فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت في بني إسرائيل (ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)؟ فقال: قد قرأت ذلك. فقال علي بن الحسين ×: فنحن القربى يا شيخ. فهل قرأت هذه الآية ( ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) ؟ قال: نعم. فقال له علي ×: فنحن القربى يا شيخ. وهل قرأت هذه الآية (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) ؟ قال: قد قرأت ذلك. فقال علي ×: فنحن أهل البيت^ الذين اختصّنا الله بآية الطهارة يا شيخ. قال: فبقي الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلّم به، وقال: بالله إنّكم هم؟ فقال علي بن الحسين‘: تالله، إنّا لنحن هم من غير شكّ، وحقّ جدّنا رسول الله’ إنّا لنحن هم، فبكى الشيخ ورمي عمامته، ثمّ رفع رأسه إلى السماء، وقال: اللهم إنّي أبرأ إليك من عدوّ آل محمّد من جنٍّ وإنس، ثمّ قال: هل لي من توبة؟ فقال له×: نعم، إن تبت تاب الله عليك وأنت معنا، فقال: أنا تائب. فبلغ يزيد بن معاوية حديث الشيخ فأمر به فقتل»[176].
ـ الشيخ الشامي: بالله إنّكم هم؟
ـ الإمام السجاد×: تالله، إنّا لنحن هم من غير شكّ، وحقّ جدّنا رسول الله’ إنّا لنحن هم.
ـ الشيخ: فبكى الشيخ ورمى عمامته، ثمّ رفع رأسه إلى السماء، وقال: اللهم إنّي أبرأ إليك من عدوّ آل محمّد من جنّ وإنس، ثم قال: هل لي من توبة؟
ـ الإمام السجاد×: نعم، إن تبت تاب الله عليك، وأنت معنا.
ـ الشيخ فقال: أنا تائب.
لا شكّ في أنّ شدّة ممارسة التضليل على المسلمين هي المسوّغ الذي جعل الشيخ الشامي يخرق قاعدة الكيف والكم[177] عبر الزيادة في مقدار المعلومات بطلب التأكيد من الإمام× عبر القسم والاستفهام والتوكيد بـ(أنّ)، وكان بإمكانه أن يكتفي بالاستفهام بقوله: هل أنتم ذوو القربى؟ فالبحث أمام معنى ظاهر وقصد خفي:
أـ المعنى القضوي الذي أحدثه الفعل اللّغوي المباشر الذي دلّت عليه القرينة اللفظية، القسم والاستفهام، والذي معناه في دلالته الحرفية تمثّل التأكيد.
ب ـ القصد المستلزم، وهو عدم الاطمئنان لما ساقه الإمام× من الاستدلالات عبر الكم الهائل من الأسئلة التي تَدرّج بها مع الشامي، والتي ستذكر في احترام قاعدة الطريقة.
وعليه؛ ينبغي ملاحظة الدقّة والعمق الكبيرين التي تتصف بهما العملية التواصلية بكل أطرافها، من مرسل ورسالة ومرسل إليه وقناة التواصل والظروف الخارجية والداخلية المحيطة، التي تكتنف عملية التحاور، وتضمن سير عملية التواصل على وفق مبدأ التعاون الإبلاغي وقواعده، فلا يكفي إطاعة الكم في تحقيق التواصل، فقد تطيع قاعدة، وتخرق أخرى، وهذا ما ستلمسه الدراسة في الفصل القادم مع قاعدة أخرى وهي الكيف. كما يبدو جليّاً ما تحلّت به العملية التخاطبية من توفير لاحترام القواعد أو خرقها، إلّا أنّها لا تستغني عن قاعدة المناسبة أو العلاقة، فهي قطب الرحى بالنسبة لمبدأ التعاون الغرايسي، فالمناسبة ضرورية وحتمية لنجاح التواصل، سواء حصل الخرق أم لم يحصل، ففي خرق قاعدة المناسبة، لا بدّ من وجود مناسبة، وهي المسوّغ عند بعضهم، ومن وجهة نظر البحث هي مناسبة، أما القدر المتيقّن مع باقي المبادئ والحكم، فهو وجود المناسبة لتحقيق التواصل.
المستوى الثاني: الخرق المختزل لقاعدة الكم
يتحقّق هذا النوع من الخرق الذي يحصل عادة في المحاورات الفردية عبر إعطاء أخبار مكثّفة ومركّزة أقلّ مما يتطلّبه التفاعل الكلامي والمشاركة في التواصل، حيث يقدّم المتكلّم أخباراً مختزلة، تكون مسؤولية قراءتها وتحليلها المفصّل على عاتق المستمع المتلقّي، ومن هذا القبيل توجد نماذج كثيرة، منها:
1ـ ما حصل مع الإمام الحسين× في أوّل خروجه من مكّة، حينما التقى الفرزدق الشاعر المشهور «فروي عن الفرزدق الشاعر أنّه قال: حججت بأمّي في سنة ستين، فبينما أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم، إذ لقيت الحسين بن علي‘ خارجاً من مكّة، معه أسيافه وتراسه، فقلت: لمن هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي، فأتيته فسلّمت عليه، وقلت له: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحب، بأبي أنت وأمي يابن رسول الله، ما أعجلك عن الحج؟ فقال: لو لم أعجّل لأُخذت، ثمّ قال لي: من أنت؟ قلت: امرؤ من العرب، فلا والله، ما فتّشني عن أكثر من ذلك، ثم قال لي: أخبرني عن النّاس خلفك، فقلت: الخبير سألت، قلوب النّاس معك وأسيافهم عليك، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء، فقال: صدقت، لله الأمر، وكل يوم ربّنا هو في شأن، (إن نزل القضاء) بما نحب، فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإن حال القضاء دون الرجاء، فلم يبعد من كان الحق نيّته، والتقوى سريرته، فقلت له: أجل، بلّغك الله ما تحبّ وكفاك ما تحذر، وسألته عن أشياء من نذور ومناسك فأخبرني بها، وحرّك راحلته، وقال: السلام عليك، ثمّ افترقنا»[178].
ـ الفرزدق: أعطاك الله سؤلك وأملك فيما تحبّ، بأبي أنت وأمي يابن رسول الله، ما أعجلك عن الحج؟
ـ الإمام الحسين×: لو لم أعجِّل لأُخذت، ثم قال لي: من أنت؟
جواب الإمام× لسؤال الفرزدق كان مختزلاً، وأقلّ مما يتطلّبه السؤال من المشاركة في التواصل، وهذا الخرق قد يشفع له سياق الحال الذي يبرر تركيز الإمام×على هدف أهم أراد الوصول إليه، وهو السؤال عن حال أهل العراق، فقصدَ الإيجاز تخلّصاً من السؤال، إلى الغرض الذي ينشده، فمقام المحاورة كان في الطريق، وقد اتّسم بالحركة والسرعة، كما يبيّنه الفرزدق بقوله: «فبينما أنا أسوق بعيرها حين دخلت الحرم، إذ لقيت الحسين...». ويمكن بيان مسوّغات هذا الخرق المختزل من الظروف الحاليّة والمقامية التي اتّسم بها الحوار، كالآتي:
أ ـ ظروف حاليّة تمثّلت بـ:
أ/1ـ زمان المحاورة؛ وقت الحج سنة ستين للهجرة.
أ/2ـ مكان المحاورة كان في الطريق عند دخول الفرزدق للحرم المكّي، وخروج الحسين بن علي÷ من الحرم؛ وقد اتّسم بالحركة والسرعة.
أ/3ـ الهيأة التي كان عليها الإمام׫إذ لقيت الحسين بن علي‘ خارجاً من مكّة معه أسيافه وتراسه[179] فقلت: لمن هذا القطار؟ فقيل: للحسين بن علي»، تُسهم في بيان المسكوت عنه في هذا الجواب المختزل، وكل تلك الظروف استلزمت حذر الإمام×وحيطته الشديدين من أن يقتل قبل أن يلبّي دعوة أهل الكوفة، وأنّ الوضع السياسي والأمني الذي كان يحيط بالإمام×والأمّة لم يكن مرضياً.
ب ـ سياق مقامي تحقق بـ:
ب/1ـ رغبة الإمام× بترك الخوض في تفصيل جواب السائل، والانتقال إلى حديث آخر يخصّ السؤال عن حال القوم خلفه وموقفهم من بيعته.
ب/2ـ مراعاة الإمام الحسين× لقدرة المتلقّي البلاغية (الفرزدق) في التوصّل إلى قصده المستلزم من هذا الجواب المختزل، فالمسكوت عنه الذي استلزمه الخرق، يتمثّل بتضييق السلطة الأُموية على الإمام، ومحاولة أخذ البيعة بالقوّة ليزيد. ومما ساعد على استنتاج القصد المسكوت عنه عوامل كثيرة، منها البحث في المسوّغات؛ فـ«اللغة لا تختزل في نظام ترميزي شفّاف للتواصل، فإنّ استعمالها وإنتاج الجمل وفهمها كل ذلك يتطلّب معارف غير لغوية، ويستلزم عمليات استدلالية»[180].
ب/3ـ كتاب الإمام× إلى أخيه محمّد بن الحنفية الذي حرره في الثاني من محرّم الحرام، وهو ظرف اقتراب موعد الحسين× مع الشهادة التي لا يسعه إلّا التذكير بها. وقد قارب ذلك الكتاب خرق قاعدة الكم عبر الخرق المختزل «بسم الله الرحمن الرحيم، من الحسين بن علي إلى محمّد بن علي، ومن قبله من بني هاشم، أما بعد، كأنّ الدنيا لم تكنْ، وكأنّ الآخرة لم تزلْ»[181]، حيث رسم لأخيه صورة تشبيهية مقتضبة، تنطوي على طباق مختزل[182]، وهو الدنيا= الآخرة، لم تكن= لم تزل.
وقد اعتمد الإمام الحسين× في هذا الاقتضاب الكمّي الشديد للألفاظ على مبدأ التعاون بينه وبين أخيه؛ لأنّ الأخير لا شكّ أنه قد سمع كلام أبيه، ولذا اتّكأ الخطاب الحسيني المختزل على هذا التعاون التخاطبي بينهما. فكأنّ الدنيا عند الحسين×قد تصرّمت، فأصبحت أثراً بعد عين، والآخرة عنده لم تزل شاخصةً أمامه يراها رأي العين لأنّه من طلّابها، بل لعلّ مسوّغ الاختزال هنا تمثل في استحضاره لكلام أبيه أمير المؤمنين× الذي سمعه أخوه ووعاه، لا سيما أنّ الإمام×قد استهلّ كتابه بقوله: «من الحسين بن علي إلى محمّد بن علي»، فكأنّه كان قاصداً التذكير بكلام أبيهما (علي). مضافا إلى ذلك ما اقتضاه السياق المقامي الذي تولّد عنه الخطاب من اختزال وتشبيه والتباس، وهو ما أنتج خطاباً متّسقاً ومنسجماً على وفق خرق الكم والكيف والطريقة. وقد أنجز الإمام× في هذا الخطاب الموجز فعلين لغويين:
الأوّل: إعطاء معنىً قضويٍ، كانت دلالته الحرفية: تشبيه الدنيا بالعدم، وتشبيه الآخرة بالبقاء.
الثاني: القصد المستلزم من هذا المعنى القضوي، وهو إيصال خبر استشهاد الإمام× إلى أهل المدينة. إذ أخبر عن نفسه بأنّه مقتول لا محالة، وهذا القصد لم يصرّح به المتكلّم، بل انتزعه المتلقّي انتزاعاً من السياق المقالي بمعونة الظروف المحيطة، والقرينة الخارجيةالتي هي خطبة أبيهما أمير المؤمنين× المذكورة آنفا.
الاستلزام الحواري في ضوء قاعدة الكيف
احترام قاعدة الكيف (Maxim Of Quality)
قاعدة الكيف: هي واحدة من أهمّ قواعد مبدأ التعاون في عملية التواصل التخاطبي، والتي تهدف إلى منع ادعاء الكذب أو إثبات الباطل. وبعبارة أخرى: لا تقُل ما تعتقد أنّه غير صحيح، ولا تقُل ما ليس عندك دليل عليه[183]. حيث يقتضي احترام هذه القاعدة من المتكلّم:
1 ـ تحرّي الصدق والاعتقاد في كل ما ينقل ويقول.
2 –أن يكون الكلام على وفق اعتقاد صاحبه؛ بأن يمتنع المتكلّم عن قول ما يعتقد كذبه أو ما ليس له دليل عليه. فيكون المقصود بالصدق هنا هو التزام المتكلّم بالمحتوى القضوي لما قيل، وتجنّب العدول من أصل المعنى؛ لكي يصل المتلقّي مع مراعاة العوامل غير اللّغوية إلى مراد المتكلّم وقصده من غير لبس أو غموض، وذلك لانتفاء القصد التواصلي مع المخاطب فيما لو أخلّ المتكلّم بالصدق.
ومما يقارب هذه القاعدة وما تستلزمه من قصد:
أولاً: توخّي الصدق والاعتقاد في كل ما ينقل ويقال
قول الإمام الحسين× في وصيّته لأخيه محمّد بن الحنفية: «بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد، المعروف بابن الحنفية: أنّ الحسين يشهد أن لا إله إلّا الله، وحده لا شريك له، وأنّ محمداً عبده ورسوله، جاء بالحق من عند الحق، وأنّ الجنّة والنار حق، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، وأنّي لم أخرج أشراً، ولا بطراً، ولا مفسداً، ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي، أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن ردّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، وهو خير الحاكمين، وهذه وصيّتي يا أخي إليك، وما توفيقي إلّا بالله، عليه توكّلت وإليه أنيب»[184].
جاء خطاب الإمام×متزامناً مع إعلانه المسيرة والخروج من مكّة إلى العراق «يوم الثلاثاء لثلاثة مضين من ذي الحجّة، وقيل يوم الأربعاء لثمان من ذي الحجّة، سنة ستين، قبل أن يصله خبر مقتل مسلم؛ لأنّه× خرج من مكّة في اليوم الذي قتل فيه مسلم رضوان الله عليه»[185]، ليحدّد الإطار العام لمسيرته ونهضته الخالدة.
ففي هذه الوصية كانت المعطيات الخبرية التي قدّمها الإمام× تعبيرات مباشرة؛ لأنّه×يمتلك الدليل القاطع على صحّتها وصدقها، ودليله القاطع مصدره ما يتمتّع به من مكانة دينية بفعل مقام الإمامة والعصمة، ومكانته الاجتماعية، فهو من سادات قريش، وابن رسول الله؛ حيث جاءت الوصيّة متضمّنة لكل مبادئ المسيرة الحسينية، صاغها بكل دقّة؛ لتكون واضحة يفهمها جميع النّاس، وهذا الوضوح يستلزم ـبطبيعة الحالـإقامة الحجّة على الجميع؛ لكي لا يعترض أحد على عدم وضوح تلك الأهداف. وهو أمرٌ يمكن أن يكون مسوّغاً له عن عدم التقاعس، فذكر في رسالته مفاصل قويّة، تمثّل صمّام أمان، يقف حائلاً أمام أيّ تهمة ضدّه، أو ضدّ أهداف المسيرة[186].
فقد جاء خطاب الإمام×مؤسّساً على مرتكزات واعتقادات راسخة ومبادئ رصينة، كان مؤمناً بها، وصادقاً في كل ما جاء بها من تفاصيل:
أ ـ سمات المسير: إمتاز الخروج الحسيني بسمات، منها: أنّ الإمام× لم يخرج:
ـ أشراً
ـ ولا بطراً
ـ ولا مفسداً
ـ ولا ظالماً
ب ـ أهداف المسيرة: لقد كانت أهداف المسيرة واضحة من خلال المقابلة بين أهداف المسيرة الحسينية وأهداف البيت الأُموي، ومتجليّة من خلال السيرة العملية للإمام الحسين×. ومع ذلك رأى تقييدها وحفظها في وصيّته لأخيه محمّد بن الحنفية، وهي:
|
ـ طلب الإصلاح |
ضد فساد بني أمية. |
|
ـ أريد الأمر بالمعروف |
ضد المنكر الذي شاع في البيت الأُموي. |
|
ـ أنهى عن المنكر |
المتمثّل بأفعال السلطة وسياستها. |
|
ـ أسير بسيرة جدّي |
سيرة معاوية وبني أمية. |
ج ـ الوصايا:
ـ إنّ الحسين×يشهد أن لا إله إلّا الله، ويكفر بكل معبود سواه.
ـ إنّ محمداً رسول الله’ سيّد الأنبياء وخاتمهم.
ـ إنّ كل ما جاء من عند الله هو الحق، وما جاء من غيره هو الباطل.
ـ إنّ الجنّة والنار حق، يستلزم الاعتقاد بالثواب والعقاب.
ـ إنّ الساعة آتية لا ريب فيها، فالدنيا فانية ولا أمان لها.
ـ إنّ الله يبعث من في القبور، وهذا ما يستلزم المعاد.
يمكننا فهم رسالة الإمام الحسين× بالتمعّن في هذه الأساسيات التي انطلقت منها المسيرة،، فقد بيّن أهدافه × بكل وضوح؛ لتكون بمتناول فهم الجميع، ولعلّ هذا من تمام المقاصد التي تتحصّل من احترام القاعدة؛ فإطاعة الحكم ومبادئ التحاور والتقيّد بها من المتكلّم بصورة مباشرة، يعتمد على قدرة المخاطب التوسّعية في فهم الكلام المنطوق، وتحليله عن طريق الاستنتاج والاستدلال المباشر المبني على افتراض أنّ المتحدّث يطيع قواعد التخاطب في الأحوال الاعتيادية[187]. وبعبارة أخرى إنّ التقيّد بمقولة الكيف يؤكّد للمتلقّي صدق المتكلّم فيما يقول، وفي ما نحن فيه يُعد التصريح بخبر ما، تلويحاً معمّماً يؤكّد اعتقاد المتكلّم بصدق الخبر[188].
تتّضح معالم احترام قاعدة الكيف لدى روّاد المسيرة الحسينية من خلال:
أ/1 خطاب الإمام الحسين× مع القوم
عند أول نزول للامام ×في أرض كربلاء، خاطب القوم قائلاً: «أيّها النّاس، اسمعوا قولي ولا تعجلوني، فإن قبلتم عذري وصدَّقْتُم قولي، وأعطيتموني النصف، كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم عليّ سبيل، وإن لم تقبلوا منّي العُذرَ، ولم تعطوا النصف من أنفسكم (ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)[189]، أمّا بعد، فانسبوني، ثمّ انظروا مَن أنا، ثمّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يحلّ لكم انتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيّكم، وابن وصيّه وابن عمّه، وأوّل المؤمنين بالله، والمصدّق لرسوله بما جاء به من عند ربّه، أوَ ليس حمزةُ سيّد الشهداء عمّ أبي؟ أوَ ليس جعفر الشهيد الطيّار ذو الجناحين عمّي...، أفما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟..، فإن كنتم في شكّ من هذا القول، أفتشكّون أثراً ما أني ابن بنت نبيكم! فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم، أنا ابن بنت نبيكم خاصة. أخبروني، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟ أو مال استهلكته؟ أو بقصاص من جراحة؟..»[190].
وعند تحليل الخطاب الآنف تظهر فيه بوادر قصديّة المتكلّم بمراعاة ما يأتي:
ـ المتكلّم هو الحسين بن علي÷، وهو إمام فرض الله على النّاس طاعته في روايات مستفيضة، وهنا يتضح معنى السلطة المعنوية العليا الممنوحة لمنتج الخطاب.
ـ الأدلّة التي ساقها المتكلّم في خطابه على أحقّيته في كل ما يدّعي، تترك المتلقّي مشلولاً حين يقف مفلساً أمام الأوامر التوجيهية التي انطوى عليها الخطاب، لا يحار جواباً.
ـ المخاطب مستحق للخروج عن مبدأ التأدّب التخاطبي، وهذا أمر خارج عن حالة الإجرائية اللّغوية، بل هو قرينة مستفادة من خارج السياق.
وعلى أيّة حال، فقد جاء الخطاب الحسيني مشحوناً بالتأدّب على الرغم من تضمّنه الأوامر المباشرة من قبيل (انسبوني، فانظروا، ارجعوا، عاتبوها، سلوا جابر، أخبروني.. )، التي تعمل على زيادة خسارة المرسل إليه، وهم أهل الكوفة الذين قدموا إلى حرب الحسين×، في حين تزيد من قيمة الذات المرسِلة للخطاب، بعد ما تُبقّي المخاطَب واجماً إزاء الأوامر الموجّهة إليه خصوصا حين لا يجد ما يمنحه التنصّل عن تلكم التوجيهات الأمرية. وقد استلزمت بداية المحاورة التي استهلّها الإمام× بـ (اسمعوني، وانظروني، ولا تعجلوني) مقاصد عدّة، منها:
الأوّل: إنّ القوم حاولوا التشويش على خطاب الإمام× واستعجاله، بل أكثر من ذلك، حاولوا أن يقطعوا خطابه؛ بسبب خوفهم من تأثّر أفراد الجيش بكلام الإمام×، فسعوا إلى مقاطعته بشتى الوسائل والسبل؛ لكي لا يفضحهم ويكشف زيفهم[191]، ما دفع عمر بن سعد أن يمتعض ويقرّع القوم بقوله: «ويلكم، كلّموه فإنّه ابن أبيه، والله لو وقف فيكم هكذا يوماً جديداً لما انقطع ولما حصر، فكلّموه، فتقدّم شمرٌ؛ فقال: يا حسين، ما هذا الذي تقول؟»[192].
الثاني: يستلزم أنّ الإمام× أراد إبراء ذمّته أمام الله؛ باعتبار أنّ للقوم عليه حقّ الهداية والإرشاد الحاكية عن حقيقة إمامته؛ فضلا عن أنّه يستلزم الوفاء بالمواثيق والعهود التي بينه وبينهم. وقد ترجم لهم الإمام×ذلك عملياً في سبيل تأدية حقوق الأمّة، فخرج بأهل بيته والثلّة من أصحابه، مُفصِحاً عن هدف خروجه من مكّة بقوله: «لم أخرج أَشراً ولا بطراً ولا مفسداً...، لطلب الإصلاح في أمّة جدّي’، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي ابن أبي طالب×»[193].
ثم انتقل في المقطع الثاني إلى أسلوب الشرط، حيث كثر توظيف الإمام×لأداة الشرط (إنْ) وهي حرف شرط جازم تفيد تعلّق وقوع الجواب على تحقّق الشرط، من غير دلالة على زمكانية وقوع ركني الجملة الشرطية[194]، متجاوزة بذلك دلالة أداة الشرط (إذا) الظرفية التي تفيد ما يستقبل من الزمان، وتكون لما تُيقّن وجوده أو رُجِّح أو كثُر، وحتميّة فعل الشرط معها أكبر، بخلاف (إن) فإنّها للمشكوك فيه[195]. ويغلب استعمال (إذا) في الأحكام كثيرة الوقوع، وتدلّ على الجزم بشرطها، وغالباً يأتي شرطها ماضياً، وإن كانت تقلبه إلى الدلالة على المستقبل[196]؛ لهذا كانت ظرفاً لما يستقبل من الزمان.
أمّا سبب قلّة استعمالها في خطابه× الذي استعمله منبّهاً فيه القوم وموجّهاً إيّاهم الوجهة الصحيحة، فيعوز إلى كونه على دراية ويقين بصفاتهم وخصالهم الدنيئة. وهذا ما نستشفه من المقاصد التي استلزمها الخطاب؛ والتي منها: فقدان الثقة واليقين من قِبَل الإمام×تجاه القوم بإمكانية تحقّق ما يدعو إليه على أرض الواقع، بل الأكثر شكّه بإمكانية تحقق ذلك من أهل الكوفة؛ فقد كانت لهم سابقة مع أبيه علي بن أبي طالب وأخيه الحسن‘.ومع أنّ الإمام×كان قاطعاً باستحالة رجوع هؤلاء القوم عن غيّهم، إلّا أنّه لم ييأس ولم يقنط من محاولة إقناعهم بإثارة بقايا المروءة العربية والأخلاق الإسلامية من القيم النبيلة كالحميّة والغيرة، لعلّه يستنقذ منهم أحداً، أو يظفر بمسلم غيور، تهتزّ مروءته لرؤية حال الإمام×، وما صار إليه أمر أهل بيته ونسائه وعياله وأصحابه في كربلاء. وهذا ما تحقق بالفعل لثلة من القوم ـ كما أثبته التاريخ ـ من قبيل الحرّ بن يزيد الرياحي.
وكيفما كان؛ فالإمام× لم يترك لهم مجالاً؛ سيما حين وضعهم أمام استفهامات توجيهية أقوى من ناحية الإنجاز التخاطبي في قصديّة التوجيه من الأمر المباشر؛ لأنّها استفهامات تقريرية، تكشف عن صدق صاحبها. ومع كونها سياقات استفهامية من حيث المعنى القضوي، إلّا أنّها في معناها الإنجازي إخبار منه بحقائق تتعلّق بذات المتكلّم، حيث أن المخاطَب على تمام المعرفة بحسب الإمام× ونسبه، مضافاً إلى ذلك مكانته العالية التي انتزعها من إقرار القوم عبر آلية السؤال والجواب «وهي طريقة حوارية بارعة، تدفع بالخصم دفعاً إلى النتيجة التي يريدها المحاور»[197]؛ حيث اختار الإمام× من الأسئلة ما يعلم أنّ إجابتها تدفع المخاطب نحو الإقرار بالنتيجة التي يريدها، وبعبارة أخرى: أنّ معناها الحرفي استفهامات، في حين المعنى المستلزم منها ـ حوارياًـعبارة عن إخبار القوم بحقائق معيّنة، وإلزامهم الحجّة. ويمكن إحصاء تلك الاستفهامات في قوله×:
ـ هل يحلّ لكم قتلي؟
ـ ألست ابن بنت نبيّكم’؟
ـ ألست ابن وصيّ نبيّكم وابن عمّه وأوّل المؤمنين؟
ـ أوَ ليس جعفر الشهيد الطيّار ذو الجناحين عمّي؟
ـ أوَ لم يبلغكم قول مستفيض فيكم: أنّ رسول الله’ قال لي ولأخي: هذان سيّدا شباب أهل الجنة؟[198].
ـ أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟
ـ أفتشكون أثراً بعد؟
ـ أتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟
ثمّ خرج الخطاب إلى مرحلة النداء؛ ليزيد في حراجة وإفلاس المخاطبين وخسارتهم، ما يجعلهم أمام واقع يعتمد على مناداتهم، والحال أنّ النداء يُخرج المنادى من العموم إلى التحديد والتخصيص، فتكون خسارته أقوى من دخوله بعموم الخطاب، ولذا نادى بقوله: «يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث»، مردفا له باستفهام تقريري إحراجي إفلاسي بقوله: «ألم تكتبوا إليّ أن قد أينعت الثمار، واخضر الجناب، وطمَّت الجمام...»، فمقتضى الحال، قد كتبتم لي قد أينعت الثمار واخضر الجناب، إلّا أنّ كلامه يستلزم قصداً أدقّ وهو: أن يا أيّها القوم، أوفوا بما قلتم، والتزموا بما كتبتم، فليس من المروءة التنصّل والنكران. ثم يرجع ×بعد ذلك إلى توجيهية النداء العمومي؛ ليكون هذا النداء السهم الأخير في كنانته التخاطبية، فيقول: «أيّها النّاس، إن كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمن من الأرض» ثم يختم بقوله: «لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفرّ فرار العبيد»، حيث كرّر النفي مرّتين؛ لتأكيد إخباره وإقراره التوجيهي لهم عبر قصديّة التوجيه، ليكشف عن ثبات في الموقف إزاء التحدّيات المحيطة به.
إنّ ما يقارب احترام قاعدة الكيف في خطب المسيرة الحسينية؛ هو حوار الإمام× مع أحد أصحابه حينما طلب الإذن بالقتال. فلما كان اليوم العاشر من المحرّم، ووقع القتال، تقدّم الحجّاج بن مسروق الجعفي[199] إلى الحسين×، واستأذنه في القتال، فأذن له، ثم عاد إليه وهو مخضّب بدمائه، فأنشده:
|
فدتـك نفسي هاديـاً مهـديّاً اليوم ألقى جدّك النبيّــا ثمّ أباك ذا الندى عليــــا ذاك الذي نعرفه الوصيّا |
فقال له الحسين×: «نعم، وأنا ألقاهما على أثرك، فرجع يقاتل حتى قتل»[200].
يظهر من الحوار أعلاه أنّ الحجّاج قد التزم بالمعنى القضوي للملفوظات، أي: الدلالة الحرفية للكلمات؛ لينجز فعلاً تأثيرياً من شأنه إيصال قصد المتكلّم بكل دقّة ووضوح، فجاء كلامه خالياً من الانزياحات اللّغوية التي تقوم على استعمال اللفظ في غير دلالته المطابقية[201] (المعجمية)؛ إذ يكون للكلام بنية سطحية من شأن عامة النّاس دركها، دون غموض أو تعقيد يتطلّب إعمالاً ذهنياً، كما هو حاصل في البنية العميقة[202]، ولعلّ الذي سوّغ للمتكلّم التقيّد بمبدأ الكيف؛ هو:
1ـ معاينته لصلافة القوم وجرأتهم في إصرارهم على قتال الإمام الحسين×.
2ـ استنفاد جميع مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي قد تتطلّب أحياناً التلميح أو الإقناع والحجاج.
3ـ مراعاة حالة الإمام×وإدخال السرور على قلبه.
كل هذه الأسباب جعلت المتكلّم يتوخّى الدقّة والوضوح في إيصال قصده بصورة مباشرة، فجاءت كلماته طافحة بالصدق؛ لأنّها صدرت عن عقيدة وإيمان بما جاء به النبي’ وأهل بيته^، حيث يكون الأسلوب المباشر في كثير من الأحوال هو الأسلوب الأكثر تأثيراً، والأوقع نفعاً، والأجدى ضبطاً لبيان الموقف[203]. وقد جاء تصريح الحجّاج بن مسروق بصورة مباشرة عبر فعل لغوي مباشر دلالته الحرفية هي الإخبار، قد دلّت عليه القرينة البنيوية المتمثّلة بالجملة الخبرية، وفعل لغوي غير مباشر استُلزِم منه صدق المتكلّم. فالتصريح بخبر ما، يعدّ استلزاماً نمطياً معمماً يؤكّد اعتقاد المتكلّم بصدق الخبر[204]، ومن هذه المقاصد:
ـ الإمام× قصد القول إنّك في طريق الحقّ؛ لأنّك ستلتقي الذوات المقدّسة.
ـ قصد تأكيد أرجوزته بحقيقة اللقيا، فضلاً عن الاستبشار للحجّاج؛ كي يزيل عنه ألم القتل بالسيف حين يكون متشوّقاً لتلك اللقيا.
ـ قصد تطمين الحجّاج ومواساته بأنّني مقتول بعدك، فلا توجل ولا تتوجّس، والقتل على الإثر فيه تلويحٌ إلى وحدة السبيل.
أ/3 ـ حواريّة مسلم بن عقيل× وابن زياد[205]
ـ ابن زياد: إيه يا ابن عقيل، أتيت النّاس وأمرهم جميع وكلمتهم واحدة؛ لتشتّتهم، وتفرّق كلمتهم، وتحمل بعضهم على بعض؟
ـ ابن عقيل: كلّا، لست أتيت، ولكن أهل المصر زعموا أنّ أباك قتل خيارهم، وسفك دماءهم، وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فأتيناهم لنأمر بالعدل، وندعوا إلى حكم الكتاب
ـ ابن زياد: وما أنت وذاك يا فاسق، أوَ لم نعمل بذلك فيهم إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر.
ـ ابن عقيل: أنا أشرب الخمر؟! والله، إنّ الله ليعلم أنّك غير صادق، وأنّك قلت بغير علم، وأنّي لست كما ذكرت، وأنّك أحقّ بشرب الخمر منّي، وأولى به من يلغ في دماء المسلمين ولغاً، فيقتلُ النفس التي حرّم الله قتلها، ويقتل النفس بغير النفس، ويسفك الدم الحرام، ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن، وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئاً.
ـ ابن زياد: يا فاسق، إنّ نفسك تُمنّيك ما حال الله دونه، ولم يترك أهله.
ـ مسلم بن عقيل: فمن أهله يا بن زياد؟
ـ ابن زياد: أمير المؤمنين يزيد.
ـ ابن عقيل: والله ما هو بالظنّ ولكنّه اليقين.
ـ ابن مرجانة: قتلني الله إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام.
ـ ابن عقيل: أما أنّك أحقّ من أحدث في الإسلام مالم يكن فيه، أما أنّك لاتدع سوء القتلة، وقبح المثلة، وخبث السيرة، ولؤم الغلبة، ولا أحد من النّاس أحقّ بها منك.
ب ـ التزام الوضوح في تقديم الملفوظات
ب/1ـ دعاء الإمام الحسين× في آخر لحظات حياته
لمّا نظر الإمام الحسين× إلى جمع بنى أميّة كأنّه السيل، رفع يدَيه بالدعاء، وقال: «اللهمّ، أنت ثقتي في كلّ كرب، ورجائي في كلّ شدّة، وأنت لي في كلّ أمر نزل بي ثقة وعدّة، كم من همٍّ يضعف فيه الفؤاد، وتقلّ فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت فيه العدوّ، أنزلته بك وشكوته إليك، رغبةً منّى إليك عمَّن سواك فكشفته وفرّجته، فأنت ولى كلّ نعمة، ومنتهى كلّ رغبة»[206].
يدلي الإمام× في هذا النصّ بحقيقة الاعتقاد الذي تربّى عليه البيت العلويّ، الذي يلمسه المتلقّي بصدق الاعتقاد المتجسّد في أقوالهم وأفعالهم، فهم^ في الأرض حبل الله المتّصل بين الأرض والسماء. حيث يستلزم من هذا الخطاب أنّ الإمام× ـ وبما لا يقبل الشك ـ صادق في كل ما يصدر منه تجاه الآخرين على طول مسيرته وحياته، فمن باب أولى أن يأتي الخطاب بكامل حمولاته الدلالية إزاء الذات الإلهية وحضرة القدس، التي تستلزم في هذا المقام مقاصد عدّة؛ منها:
ـ إظهار كامل العبودية والعجز والافتقار لله سبحانه وتعالى.
ـ خروج الجمل الخبرية من مقام الإخبار واستلزامها فعلاً إنجازياً آخر، لم يقصد منه الإمام×المعنى القضوي الذي أفادته الدلالة الحرفية لعناصر التركيب، ألا وهو الاعتراف لله سبحانه وتعالى أمام جميع الخلق، وبيان حسن توكّله على الله في جميع أموره، فالله ثقته وعدّته في جميع أحواله، وإنّما قصد منه شيئاً آخر وهو: خروج ذاك الفعل اللّغوي المباشر الذي دلّت عليه الجمل الخبرية إلى إنجاز فعلٍ لغوي غير مباشر، أفاد طلب الدعاء؛ أي: (اللهم كن أنت ثقتي...) إلخ.
ـ رسالة تحمل قصدين: قصد تطميني لأصحابه بأنّهم سينالون الشهادة والنصر على أعدائهم، فبدمائهم يحيى الدين، وتستمرّ تعاليمه. وآخر تعريضي بالآخرين الذين يتخذون الظالمين والفاسقين عّدتهم، وثقتهم، ورجاءهم في جميع أمورهم، ولا شكّ أنّ النصر سيكون حليف من كان الله ثقته ورجاءه وعدّته.
والإمام×بوصفه خليفة الله ـ مع قصر الخطاب ـ يقدَّم دليلاً على صحّة اعترافه لأولئك الذين يجهلون حقيقته ومنزلته من خلال سوقه للفعل اللّغوي المباشر الذي خرج إلى الاعتراف وقد دلّت عليه القرينة (كم الخبرية)، فضلاً عن إنجاز فعل التعداد الذي استلزم منه إقامة الدليل على كل ما تقدّم. فكأنّه قصد إيهام الجميع بأنّ ما نزل به قديم، وما هو كائن من الهموم والبلاء، قد أنزله بساحة القدس الإلهية رغبة، والرغبة أضافت معنى السعة عن طريق السؤال والطلب، مما يقتضي الإلحاح في الطلب على وجه السعة[207] والكثرة، ففي الدعاء: «إليك رغب الراغبون، فرغبة هو من قولك رغب في الشيء كسمع، يرغب رغبة: إذا حرص عليه وطمع فيه، والهاء في رغبة لتأنيث المصدر»[208].
ومن دعاء الإمام الحسين× قبل الاستشهاد:
«اللهم أنت متعالي المكان، عظيم الجبروت، شديد المحال، غنيّ عن الخلائق، عريض الكبرياء، قادر على ما تشاء، قريب الرحمة، صادق الوعد، سابغ النعمة، حسن البلاء، قريب إذا دُعيت، محيط بما خلقت، قابل التوبة لمن تاب إليك، قادر على ما أردت، ومدرك ما طلبت، وشكور إذا شُكرت وذكور إذا ذُكرت. أدعوك محتاجاً، وأرغب إليك فقيراً، وأفزع إليك خائفاً، وأبكي إليك مكروباً، وأستعين بك ضعيفاً، وأتوكّل عليك كافياً، احكم بيننا وبين قومنا بالحق، فإنّهم غرّونا وخدعونا وخذلونا، وغرّروا بنا وقتلونا، ونحن عترة نبيّك، وولد حبيبك محمّد بن عبد الله، الذي اصطفيته بالرسالة، وائتمنته على وحيك، فاجعل لنا من أمرنا فرجاً ومخرجاً، برحمتك يا أرحم الراحمين»[209].
نستشف من خلال الوقوف على الظروف المحيطة بهذا الخطاب، أنّ الإمام×قد قاله في آخر لحظات حياته، حين توسّد التراب، وتكاثر عليه الأعداء ليُقطّعوه بعد ما أثخنته الجراح. إذ لا شكّ أنها كانت ظروفا عصيبة، تجعل الإنسان يذهل بنفسه عما سواه، إلا أن الأمر يختلف عند الحسين×، فهو يدرك تماماً أنها أقرب لحظات الوصال مع معشوقه. لهذا يمكن عدّ كلماته في هذا الخطاب خرقاً مقامياً لمثل هكذا حالات، فقد انقطع عن نفسه وعن قاتليه وعن عياله إلى الله؛ ليرسم لوحة الانقطاع الفنّية بكلماته التقديسية، مخالفاً نواميس الطبيعة، فإنّه لا يعبأ بسوى المعبود، جاعلاً من معبوده سكناً لطمأنينيته وسعادته حين بثّ شكواه، بعد ما عجز عن عتاب قاتليه، منتقلا من الشكاية الدنيوية إلى الأخروية، ومن النصرة البشرية إلى التعزية الإلهية.
ب ـ2 خطاب العقيلة زينب‘ ليزيد في الشام:
«والله، ما اتقيت غير الله، ولا شكواي إلّا إلى الله، فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا يرحض عنك عار ما أتيت إلينا أبداً، والحمد لله الذي ختم بالسعادة والمغفرة لسادات شبان الجنان فأوجب لهم الجنّة، أسال الله أن يرفع لهم الدرجات، وأن يوجب لهم المزيد من فضله فإنّه ولي قدير»[210].
وقولها أيضاً: «فمهلاً مهلاً، لا تطش جهلاً، أنسيت قول الله}: (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)[211]أمن العدل ـيا ابن الطلقاءـتخديرك حرائرك وإماءك، وسوْقك بنات رسول الله’ سبايا! قد هتكت ستورهن، وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفّح وجوههن القريب والبعيد والدنى والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي، ولا من حماتهن حمي»[212].
هنا جاء النهي من السيدة زينب‘ مع كونه طلباً بالكفّ عن الطيش، وأساليب الطلب لا تصدر إلّا من صاحب سلطة عليا إلى من هو دونه رتبةً، فلا فرق بينه وبين الأمر، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء[213]. ومع هذا يمكن أن تترشّح عنه معانٍ عدّة مستلزمة:
أولا: مقصد سياسي تمثّل في أنّها‘أرادت أن تلفت انتباه يزيد ومن في مجلسه بأنّها أعلى سلطة من يزيد، وأنّها مع ماهي عليه من عظم المصاب إلّا أنّ مركزها الدينيّ وسلطتها المعنوية باقيان؛ لانتسابها إلى البيت العلوي، وإن ادّعى يزيد اغتصابهما، وهو ما أفادته قوّة الحجّة التي حاججته بها حين قالت ‘: «لَكَ مُسْتَوْسِقَة، والأُمُورَ لَدَيك مُتَّسِقَة، وَحِيْنَ صَفَا لَكَ مُلْكُنَا، وَخَلُصَ لَكَ سُلْطانُنَا»[214]. فمع أنّ المقام هوأن السيدة زينب ‘ كانت أسيرة مقيّدة، إلا أنّ مقامها الإلهي ونسبها الطاهر قد خوّلها الأمر والنهي، كاشفة من خلال ذلك عن بطلان حكم يزيد، وغصبه من أهله ومستحقّيه.
ثانيا: مقصد أخلاقي، فقد جاء النهي ممزوجاً ومشبعاً بالتحقير والإهانة. فهي أرادت عبر تمثّلها تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن توجّه المتلقّي إلى الكفّ عن الطيش. إذ لا منكرَ أعظمُ من قتل الحسين×، وانتهاك حرمته الطاهرة.
وقد عرَّضت العقيلة‘ بعدالة هذا السلطان الجائر من خلال سوق ما يثبت جهله وحماقته؛ إذ يخدّر حرائره وإماءه، في الوقت الذي يسبي بنات رسول الله’. وهذا ما ينبأ أنّها ‘ استثمرت جملة من الظروف التي اكتنفت الخطاب، ومنها:
ـ الحشد الكبير من النّاس والوجهاء المضلّلين، الذين شهدوا اعتداء يزيد على الرأس الشريف والعترة.
ـ الخطاب حصل في عقر دار يزيد، وفي عِظم الشعور بنشوة النصر والغطرسة[215].
ـ الحالة النفسية المتناقضة التي كان عليها طرفا الحوار.
ـ التعدّي السافر على الرأس الشريف من الطاغية ـ عندما أخذ ينكث ثنايا أبي عبد الله بمخصرته ـ مع سكوت أغلب الحاضرين وخنوعهم، من أهل الشام الذين شاهدوا انتهاك حرمة الرأس الشريف.
وقد أفادت السيّدة زينب‘ من ظاهرة التكرار في النفي، في الجمع بين لا النافية والفعل المضارع ـ وذلك في الخطبة نفسها ـ كي يعطي هذا التكرار (لا تدرك، ولا تبلغ غايتنا، ولا تمحو ذكرنا) معنيين دلاليين:
المعنى القضوي: المتمثّل بدلالة عناصر التركيب المعجمية، والنحوية، أي: الدلالة الحرفية، وهي الإخبار.
القصد المستلزم: استلزام النهي والنفي تعجيزَ المتلقّي، وإعلامه أنّه مهما حاول جاهداً، فإنّ جميع محاولاته ستبوء بالفشل. وهنا يبرز معنى آخر؛ وهو التعريض بمحاولات معاوية من قبل، إذ على الرغم مما كان يتمتّع به من قوّة إلا أنّه لم يتمكن من بلوغ مآربه، فما بالك بيزيد.
ما دام الخطاب السياسي خطاباً تأثيرياً، يهدف إلى التأثير في الآخر، ويجعله يبادر إلى العمل[216]، فبطريق أولى يكون الخطاب الديني ـ هو الآخر ـ خطاباً تأثيرياً إقناعياً، هدفه التأثير في المخاطَب المتلقّي، وبعثه على إيجاد فعل عملي يسانخ ذلك المخاطب.
وعليه؛ يمكننا القول أنّ الغاية من تنوّع الوسائل في التواصل الخطابيّ، هي ايجاد تأثير في المخاطب عبر إقناعه. ولا يكفي تعدّد الطرق، إن لم يكن هناك تمكّن من اللّغة وأدواتها، فتتراوح أساليب التأثير بين الوضوح الحاصل من الأفعال اللّغوية المباشرة ودلالتها السطحية، وبين المجاز والانزياحات اللّغوية التي تتحصّل من الفعل اللّغوي المباشر بمعونة مجريات الأحداث والسياق المقامي، مع وعي المخاطب بأسس التواصل، وتسلّطه على ناصية اللغة وأدواتها، للوقوف على مقاصد المتكلّم، متوخّياً في ذلك مقاربة المعنى من القصد المطلوب، ومستبعداً الدلالة الظاهرة للتركيب عبر سلسلة من الاستدلالات العقلية التي تربط بين علاقة الفعلين المباشر وغير المباشر. حيث يقتضي الإخلال بهذه القاعدة والاستخفاف بها حصول أغلب أنواع الصور البيانية، من التشبيه والاستعارة والكناية والتهكّم والتلويح والمبالغة.. إلخ[217]. وبالنظر لأهمّية أكثر نصوص مادة الرسالة وقداستها؛ فلا يصح أن تبقى هذه القاعدة على صياغتها، وبالأخص عندما يحصل الاستخفاف بها، فيكون ناتج الخرق الكذب وإبلاغ ما لا برهان أو دليل على صحّته، مع الالتفات إلى أنّ المقصود من الكذب ليس بمعناه غير الأخلاقي؛ لذا تقرّر تعديل صياغة القاعدة؛ لتتناسب مع هذا المحذور الأخلاقي، وعلى وفق الآتي: «تقيّد بدلالة الألفاظ المعجميّة أي: بدلالتها الحرفية، وتجنّب الانزياحات المجازية» وبذلك يكون التزام المتكلّم بالدلالة الحرفية للكلام، والتقيّد بمعناه المعجمي، مصداقاً لتحقيق الاتصال المباشر، بلا لبس أو غموض، ويكون الخرق حاصلاً من تجاوز الدلالة الحرفية والمستوى المعجمي، في صياغة متواليات الخطاب إلى الصور البيانية والانزياحات المجازية، لبلوغ مراد المتكلّم ومقاصده[218]، والاستخفاف في قاعدة الكيف وهو ما عليه أكثر خطب المسيرة الحسينية، التي إتّكأت على الوسائل البيانية من التشبيه والاستعارة والكناية، فهي أجدى في تقريب الصورة إلى ذهن المتلقّي، وأبلغ في الإقناع والتأثير في السامع؛ لأنّ الفكرة التي تقفزُ إلى ذهن المتلقّي، تعتمد دائماً «صياغة اللّغة، أو بناء صورة أسلوبية من مادّة لغوية»[219]. وسيتناول البحث المقاصد الناتجة عن خرق هذه القاعدة على ثلاثة مستويات:
وهو من أبرز مباحث علم البيان، الذي تنتهي دلالته إلى المجاز[220]، وهو خلاف الحقيقة، فإذا كان الخطيب أو منتج الخطاب يبتعد في التشبيه عن الدلالة الحقيقة ويتجاوزها منتهكاً المدلول اللفظي على المستوى المعجمي، فإنّه يكون بذلك مستخفّاً بقاعدة الكيف التي تقرّر أنّها تنصّ على التمسّك بالدلالة الحقيقة؛ لأنّ طرفي التشبيه ـ في الغالب ـ إنّما يلتقيان ويتشابهان بالمقارنة على المسامحة والاصطلاح لا على الحقيقة[221]
صدَّر الإمام الحسين×خطابه[222] ـبعدذكرالله تعالى ـ بقوله: «خُطَّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة»[223]، حيث جاء بناء الفعل الماضي (خُطَّ) للمجهول؛ ليدلّ استلزاما أنّ الاهتمام اللّغوي للخطاب جاء منصبّاً على حدث الفعل المبني للمجهول الذي لا تؤدّيه آليات الفعل، فيما لو كان الفعل مبنيّاً للمعلوم[224]، أي: أنّ الدلالة التي يريدها النص هي دلالة الحدث الفعلي من خلال إسناد الفعل إلى نائب الفاعل (الموت) الذي هو المقصد الحقيقي لتوظيف الخطاب، وهي من الصور البلاغية الجميلة التي تستلزم حمل الشحنة الخطابية العميقة لمكنون النص التوصيفي للحياة السرمدية. إذ قلّما يتناولها المبدعون في تحويل الصورة المخيفة للموت، وما تتركه من جانب نفسي يبعث الوجل والهلع والخوف في نفوس سامعيه، فتجعل ذكر الموت من مناشئ الطيرة عند الكثيرين، إلاّ أن الإمام× قد ألبسه اللباس الذي يرفع منه الصورة المأساوية؛ ليزيّنه للآخرين بهذه الهيأة التي تجتذب السامعين، لا سيما أنّ الإمام×كان يعيش لذّة الأنس بلقاء اللهUبعد الموت، التي قلَّما يشعر بها النّاس. فكان قصده عبر هذا الخرق أن يذيقهم حلاوة هذا الأنس من خلال براعته في استعمال خرق هذه القاعدة، مستخدماً ريشة التشبيه في رسم هذه الصورة الرائعة، المنبئة عن شعوره بحاجة الأمّة إلى هذا اللقاء. كما جاء نداؤه مستلزماً للاستنصار الجماعي، وهو توظيف بلاغي يهدف إلى تصوير العالم الماورائي (الميتافيزيقي) كونه من العوالم المعنوية غير المحسوسة بصورة فنّية حسّية جميلة، تبعث الراحة والانجذاب والشوق لدى المتلقّي؛ لأنّ لفظ الفتاة مما يشعر السامع بنوع من التفاؤل والوئام والعطف والإستقرار[225]، فهو تشبيه من نوع التشبيه البليغ، إذ حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه، وقد عُدَّ من أرقي أنواع التشبيه عند السكّاكي(ت626هـ)[226]، إذ تتجلّى فيه معالم التصوير الفنّي لحقيقةٍ حتميةٍ يصفها القرآن لشدّة هولها بأنّها مصيبة، كما في قولهI: (إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ)[227] وهي من الحقائق التي لا بدّ منها؛ إذ أنّها مآل كل المخلوقات بلا استثناء، في حين أنّ الإمام×كان قد وجّه خطابه إلى بني آدم من دون غيرهم[228]، ذلك لأنّ الغاية والقصد من وراء الخطاب هو التوظيف التعبيري المشحون للتأثير في المتلقّي، وحثّه كي يركب مع الحسين×سفينة النجاة العازمة على الرحيل، فكان على الحسين×أن يوظّف بلاغته من أجل توضيح نداء الاستنصار عبر تحديد المضمون بموضوع النصرة، وهم السامعون من الرجال كونهم الأدوات الحقيقة للثورة.
يشترط علماء البلاغة المتقدّمون أنْ تكون ثمّة علاقة تلازمية ما بين المشبّه والمشبّه به؛ كي تكتمل الصورة التشبيهية لدى المتلقّي، وحتى لا يجد هذا الأخير نفسه أمام عمل إبداعي عقيم، يخلو تماماً من الصورة الإبداعية لخلوّه من التصوير التشبيهي المألوف.
وعليه؛ لا بدّ من توفر جهة جامعة بين المشبّه والمشبّه بهِ، وهو ما يعرف عندهم بوجه الشبه، الذي لا يشترط وجوده في النصّ، بل يكفي اشتراط ارتسام صورته القريبة في أذهان السامعين، وأن يكون غير بعيد عن الذوق المألوف. فهل تخلّى الخطاب الحسيني الآنف عن أسس التشبيه المألوفة أو لا؟
لكي ننتزع الجواب المناسب عن هذا السؤال؛ أرى أنني ملزم بسبر أغواره من خلال استعمال بعض الآليات اللّغوية والتداولية في عملية الاستنطاق، والتي من شأنها معرفة المسوّغات والظروف التي تكتنف الخطاب:
أـ يُستشعر للوهلة الأولى أنّ حتمية الموت على بني البشر لا تتناسب مع تشبيهه بالقلادة التي يستعملها ويتقلّدها القليل من الفتيات.
ب ـ فالواقع يحكي بأنّ قلادة العنق وقف على الميسورات من النساء[229]، فليس من داعٍ أن تكون مورداً لأن تشبّه بالموت الحتمي على بني البشر، إذ ليس من التلازم في شيء أن تكون القلادة مورداً لتشبيه الحتميات؛ لأنّ الملازمة بين القلادة وبين العنق ليست من مصاديق الملازمة العقلية كي تكون مشبّهاً به في المقام، كالملازمة بين بني آدم وبين الموت الذي توطّده الآية الشريفة (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ)[230]. نعم يبقى ثمّة توجيه آخر يعتمد على فهم المراد (القصد) لأنّنا أمام كلام الإمام المعصوم، وكلامه من القداسة بمكان، فالإمام الرضا× يقول: «إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن، ومحكماً كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا»[231].
وعليه؛ (خطّ الموت) في حقيقته وواقعيّته وحتميّته كحتميّة كون القلادة خطّاً على عنق الفتاة، وليس على مكان غيره[232]، فالقلادة سمّيت كذلك؛ لأنّها تكون معلّقة في العنق، ولا ريب أنّ تأرجحها على الأعناق مما لا يقول بخلافه أحد. وبعبارة أخرى: كل قلادة تكون معلّقة على أعناق الفتيات، وليس كل الفتيات ترتدين القلائد، فالكلام إذاً في حتمية تدلّي القلادة على أعناق الفتيات، وهذا لا محيص عنه، وهو المقصود من وراء هذا الخرق في قواعد الحوار، في حين يفرّق بعضهم بين اسم المكان واسم المصدر في كلمة (مخط)، فإن كان المراد منها اسم المكان فهي جلدة العنق التي لا تنفصل عنه، كما لا ينفصل الموت عن ولد آدم، وإن كان اسم المصدر فهي كالدائرة التي تطوّق الجيد، فلا يخرج منها، كما أنّ الموت يطوّق صاحبه[233].
ومن اللافت للنظر أنّ الإمام×لم يكن وحده من يستذوق طعم الموت وحلاوته في سبيل المعاني السامية، بل سرى هذا الاستشعار إلى رجال النهضة جميعهم من غير وقف على واحد بعينه. حيث صار الموت دون الحسين×لديهم سبيلا للإشراف على السعادة الأبدية التي لا يستشعرها الجاهل بحقيقة سيّد الشهداء×. فهذا القاسم بن الحسن× الذي يقول عنه المؤرّخون بأنّه لم يبلغ الحلم، يسأله عمّه الحسين× قائلاً: «يا بني، كيف الموت عندك؟» فيجيبه: «يا عم أحلى من العسل»[234]، وكما يروي الشيخ المفيد(ت413هـ) في إرشاده: أنّ الحسين×في طريقه إلى كربلاء جعل يقول: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين، ففعل ذلك مرّتين أو ثلاثاً، فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين‘ على فرس، فقال: ممَ حمدت الله واسترجعت؟ فقال: يا بني، إني خفقت خفقة فعنَّ[235] لي فارس على فرس، وهو يقول: القوم يسيرون، والمنايا تسير إليهم، فعلمت أنّها أنفسنا نُعيت إلينا، فقال له: يا أبتِ، لا أراكَ الله سوءاً، ألسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد، قال: فإنّنا إذاً لا نبالي أنْ نموت محقّين، فقال له الحسين×: جزاك الله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده»[236].ومن هذه المقاصد التي خرج إليها هذا الخطاب:
1ـ الشوق إلى لقاء المعشوق
ينطوي الخطاب الحسيني، بالإضافة إلى ما سبق، على وصف للحالة التي تغمر الإمام×، كالوله والشوق للقاء أسلافه الذين فارقوه، وهم جدّه المصطفى’، وأبوه علي×، وأمّه فاطمة‘، وأخوه الحسن×، وقد أفصح عن هذا الشوق بقوله: (وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف)، ليكشف لنا مدى الشوق الذي يعتصر قلبه المقدّس للقاء الأحبّة الذين سار على خطاهم التي بلغوا بها مقام رضا اللهI، مما ينبئك عن عظم الوشيجة التي تربطه بتلك الذوات المقدّسة من أصحاب الكساء، وهو شوق إلى المقامات الرفيعة العالية المدَّخرة لهم وللحسين×نفسه، إذا ما سار على الخطى المقدّسة لهم؛ لينالها بمقام الشهادة[237]. وقد جاء تشبيهه لشوقه بشوق نبي الله يعقوب×إلى معشوقه النبي يوسف× حتى أذهب بصره، كما يعبّر القرآن الكريم عنه بقوله: (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)[238]، ولعلّ اللافت للنظر أنّ هذا الكلام من الإمام الحسين×قد يستبطن ذمّاً ـ في الجملة ـ للأمة الإسلامية التي لم تعرف حق الحسين، فتركته غريباً، يستصرخ أسلافه الموتى. وهو ما يكشف عن تذمّره من الدنيا وأهلها، حيث تجلّى هذا الشعور جليّاً حينما زار قبر جدّه المصطفى’، فقال له ـ حين رآه في المنام ـ: «يا جدَّاه، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، فخذني إليك، وأدخلني معك في قبرك»[239].ناهيك عن المواقف الأخرى التي يكفي الباحث الإطلاع عليها ليستشف مدى أنس الحسين× بالموت، جاعلاً من الموت القنطرة التي توصله للقاء اللهI، والتي جسّدها بكلمات نثرية وشعرية، منها:
ـ قوله في مسيره إلى كربلاء: إنّي لا أرى الموت إلّا سعادةً، والحياة مع الظالمين إلّا برما[240].
ـ وقوله مخاطباً عبد الله ابن الزبير: يا ابن الزبير، لأن أدفن بشاطئ الفرات أحبّ إليّ من أن أدفن بفناء الكعبة[241].
ـ وأنشد يوم عاشوراء: الموت خير من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار[242].
فقول الإمام×يحمل شحنتين دلاليّتين:
المعنى القضوي: هو الدلالة الحرفية (المعجمية) لعناصر التركيب، وهو الإخبار
القصد المستلزم: قصد الإمام×إصراره على المضي قدماً في مواصلة هدفه الذي خرج من أجله، وهو الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسير بسيرة جدّه حتى الاستشهاد. ذلك المسار الآمن من عار الخنوع والخضوع للظالمين في إعطاء البيعة.
إنّ الإمام×في كل ما تقدّم من متوالياته اللفظية، وتمام الاعتقاد وكماله في ما يفعل ويقول، يمتلك الدليل القاطع على صحّة أقواله بدليل قوله: «ألا وأنّ الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلّة والذلّة، وهيهات منّا الذلّة، يأبى الله لنا ذلك، ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، وأنوف حميّة، ونفوس أبيّة، من أن نؤثر طاعة اللئام، على مصارع الكرام»[243]. ومدلول هذا الكلام أنّكم (أيها القوم) إذا كنتم تحسبون القتل، وسفك الدماء، وسبي النساء، وحرق الخيام ـ التي هي من عادات الجاهلية ـ وتقطيع الأجساد عاراً، فإنّ هذا العار الذي يلحق الإنسان لأجل مبدأ إحقاق الحق هو أولى من دخول النار، الذي ستجزونه بسبب خوفكم وخنوعكم، وهو أمرٌ سيجعلكم مستحقّين له عاجلاً غير آجل، ذلاً ومهانةً في الدنيا وعذاباً أليماً في الآخرة.
ـ وأنشأ مخاطباً الحرّ بن يزيد الرياحي ـحين قال له الحرّ: ارجع إلى حرم جدِّك، فإنّك مقتولـ:
|
سأمضي
فما بالموتِ عارٌ على الفتى |
إنّ المعنى الحرفي لهذه الأبيات، هو دلالتها الحرفية على الإخبار. أما المعنى المستلزم؛ فهو تصميم الإمام×وعزمه على إحدى الحُسنيين، إمّا النصر وإمّا الشهادة، اللذين علّلهما بالآتي:
علّل النّصر بتحقيق ما خرج من أجله، وبالتالي لا حاجة للندم واللوم ما دام قد تحقق النّصر، وعلّل الشهادة، بوصفه إماماً أدّى تكليفه الشرعي والأخلاقي على أتمّ وجه، فلم يكن الموت عنده سوى برزخ يصل به إلى السعادة الأبدية، ويحصل به على المقام الذي ادَّخره اللهI له بعد شهادته في كربلاء. وهو من المعاني التي لم يفهمها معاصروه، فكان عليه أن يسعى لتبيين هذه الحقيقة لغيره، وهو انتقال من الخطاب العام إلى الخاص؛ ليكشف عن مكنون الخطّة الحسينية المُفضية إلى الشهادة. وهذا ما استّقر في نفس الحرّ بعدما أدرك من خلال تلك الأبيات قصد الإمام×، قال الطبريّ: «فلمّا سمع ذلك منه الحرّ تنحّى عنه، وكان يسير بأصحابه في ناحية والحسين× في ناحية أخرى، حتّى انتهوا إلى عذيب الهجانات»[245].
2ـ الإخبار الغيبي
انتقل الإمام×بعد ذلك إلى ملامسة البعد الغيبي ـ من خلال ما يجري عليه بالتحديد ـ لما ستنتهي إليه هذه الرحلة الطويلة، وذلك حين وصف حقيقة ما سيجري بالوصف ذاته الذي بدأ به، وهو الإخبار بالفعل الماضي المبني للمجهول في قوله: (وخير لي مصرع أنا لاقيه)؛ لكي يعبّر الفعل المبني للمجهول عن حقيقة بلاغية لا يحقّقها غيره من الأفعال، أو لا يحقّقها الفعل نفسه لو كان مبنيّاً للمعلوم، وذلك بالتركيز على الشحنة الدلالية للحدث الذي يحمله فعل الاختيار؛ ليكشف للسامع دوافع التخطيط الإلهي لهذا الخروج، وأنّه لم يكن إرادياً بالمعنى الدقيق؛ لأنّه بُلِّغ بضرورة الخروج سلفاً، وأنّ المسألة ليست منوطة بالخروج فقط، إنّما المراد هو تحديد ما يترتّب على خروجه حينما جعل الفعل مسنداً إلى نائب الفاعل (مصرع) الذي يصوّر تلكم النتيجة، بعدما أخفى النصّ الفاعل الذي كان وراء الاختيار المذكور لهذا المصرع الحتمي؛ لكي يكشف قصده ويوصله، كونه يسير بأمر من السماء. وبذلك يتسنى للمخاطب والسامع فهم أن الإمام×يسير على خطى مرسومة له مِن قِبل مَن لم يصرّح باسمه في خطابه، الأمر الذي يجعل السامع أمام هذا النصّ البلاغي الجميل الذي يقتضي الإذعان لطلب الخطاب المستلزم للنصرة يركّز على درك أنس الإمام الحسين× بلقاء الله، بدلا من أن يفتّش عن الآمر له.
ومع ذلك لم ينفِ بالمرّة إرادته في تحقيق هذا التخطيط الإلهي المأساوي وتلبيته، ولهذا قلت: لم يكن إرادياً بالمعنى الدقيق، وهذا الإطلاق التركيبي للسياق له قيمته العقدية في زمن الحسين×؛ لأنّ الأمّة تعيش سبات المخدِّر الأموي القائم على سيادة الأمّة، وحكمها واستعبادها تحت عنوان حاكمية الله التي يمثّلها الخليفة الأُموي بالاعتماد على بعض الروايات الموضوعة، التي تسند هذه الفرية المخالفة للأسس والثوابت الدينية الحقّة. وهذا ما يجعل هذا الأمر حاضراً في الخطاب الأوّل للإمام×، حين قال: (أنا لاقيه)، ليجمع بين الأمر الإلهي وبين حرّية التنفيذ والخضوع والاختيار للقضاء الإلهي، وفي هذا يتجسّد ما عليه الفكر الإمامي إزاء توجيه الأفعال الصادرة على أساس ديني والمستمدّة من كلام المعصومين^ أنفسهم، التي تقضي بأنّ أفعال الإنسان إنّما هي برزخ بين الجبر والتفويض، فلا هي محكومة للجبر المحض، ولا التفويض المحض، إنمّا هي أمر بين أمرين[246]، فقول الحسين×: (أنا لاقيه) يستلزم دلالةً واضحة لإرادته في اختيار هذا المبدأ، في حين أنّ الواقع ينبئُ بأنَّ الموت هو ما يبحث عن صاحبه لا العكس، بدلالة قول أمير المؤمنين× ـ لما أراد الخروج إلى المسجد في الليلة التي ضُرِبَ فيها ـ: «أشدد حيازيمك للموت فإنَّ الموتَ لاقيكا»[247].وبضمّ الشاهدين المذكورين؛ يتضح لنا:
المعنى القضوي: أنّ الموت هو الذي يرصد مطلوبه ويلاقيه.
القصد المستلزم: الإمام الحسين×أراد أن يصوّر ـ توظيفياً ـ بأنّه سعى إلى حتفه مختاراً وملبّياً ومسلِّماً لإرادة السماء، على الرغم من الجانب المأساوي فيه كما يصوّره هو×.
ومادمنا نبحث في الخطاب الحسيني المستنهض لهمم الجماهير في مرحلة متقدّمة على عاشوراء، لذا ينبغي الإشارة إلى الصورة الحتميّة لما سيقدم عليه الحسين×، من خلال الدلالة الحرفية للملفوظات التي يحملها الوصف (لاقيه)، ولا شكّ في أنّه من الأوصاف الاشتقاقية في اللغة العربية المسمّى باسم الفاعل، والذي لا يعمل عمل فعله إلّا بشروط يذكرها علماء النحو في ذلك من قبيل: أنّه لا يعمل إلّا معتمداً على نفي أو استفهام، أو يكون خبراً أو حالاً وغيرها من شرائط عمله التي يقول بها البصريّون[248]، كما ينبغي أن يدلّ على الحال والاستقبال حين يكون مجرّداً من (أل) التعريف كشرط آخر من شرائط عمله، وأمّا إذا دلَّ على الزمن الماضي فلا بدَّ من إضافته إلى معموله، فلا يكون عاملاً حينها، ولكن الواقع اللّغوي، لا سيما في الدرس اللّغوي الحديث، يرى أنّ عمل اسم الفاعل ودلالته الزمنية من المسائل التي تقع تحت تأثير السياق اللّغوي بما توظّفه الدلالة النحوية داخل التركيب السياقي، بعد تضافر القرائن الموصلة إلى القصديّة المتوخّاة من دلالات سياقيّة.
وعليه؛ تكون دلالة اسم الفاعل فيما نحن فيه، على الزمن المستقبل الذي أنبأ به الإمام الحسين×في الإخبار عن مصرعه الذي هو من سيقدم عليه ويلاقيه، مع أنّه جاء مضافاً، فيلزم بناءً على المذهب البصري أن يكون دالاً على الزمن الماضي، في حين أنّ المصرع الذي يذهب إليه الإمام× يقع ـلا محالةـفي الزمن المستقبل؛ لأنّه لم يكن قد وقع في زمن الخطاب، وهذا المعطى أوصلنا إليه النصّ متماسكاً؛ ليكشف عن الوظيفة السياقيّة التي يحدّدها قصد المبدع لا غيره.
وهذه الصيغة الصرفية التي ينبغي ـ بَصْرياً ـ أن تدلّ على الماضوية الزمانية يمكن أن تجعلها القرائن السياقيّة المقاميّة مستلزمة للدلالة على الزمن المستقبل، وعلى حتميّة حدوث المصرع المستفاد من الوظيفة المقامية لحال النصّ وزمانه. لكن يبقى القول إنّ اسم الفاعل يحتمل دلالة أخرى، تضاف إلى دلالته السابقة، وهي دلالته على الثبوت والدوام[249]، خلافاً للفعل الذي يدلّ على التجدّد[250]، ومن هنا سمّاه الكوفيّون بالفعل الدائم[251]، كونه يدلّ على ديمومة الحدث وثبوته وقراره، الذي لا يستطيع الفعل أن يدلّ عليه، فاسم الفاعل هنا استلزم التعبير عن حتميّة وقوع المصرع، الذي لا تكشفه الوظيفة السياقية للفعل، فضلاً عن الدلالة الصرفية له، على العكس من اسم الفاعل. فالدلالة الصرفية التي تحملها بنية اسم الفاعل بالتعاون مع الدلالة النحوية داخل التركيب السياقي، تفضي إلى حتميّة المآل المفضي له الخطاب الحسيني غير القابل لريب أو شكّ أو زعزعة موقف؛ ليعلم السامع من خلال هذا الخرق الحواري جليّاً بيقينية الذهاب إلى العراق، ويقينية الموت الذي سيؤول إليه هذا الذهاب[252].
3ـ حيّ على الشهادة
ينتقل أبو الأحرار×إلى المضمون الفعلي لخاتمية الثورة الحسينية، كاشفاً عن أحقّيته بالنصرة من غيره بوصفه الإمام المفترض الطاعة على أبناء الأمّة الإسلامية، إذ انتقل من الصيغ الإخبارية للخطاب التوصيفي التي تضمّنها النصّ الحسيني منذ بدايته إلى أن صار يستنصر النّاس للخروج معه، فانتقل النصّ من الصيغ الخبرية الوصفية، إلى الصيغ الطلبية الإنشائية الأمرية بقوله: «من كان فينا باذلاً مهجته، موطّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإنّي راحلٌ مصبحاً إن شاء الله»[253] وليس هذا تغيّراً عفوياً في الصيغ الاستعمالية التركيبية للخطاب، وإنّما هو انتقال مقصود إلى الغاية التي وُظّف الخطاب من أجلها، وهي استنهاضٌ لهمم أبناء الأمّة؛ أي: هو جزء من الدلالة التوظيفية للتغيّر الصرفي في السياق النحوي للتعبير عن مكنون النصّ حين يصل إلى ما وُظِّف من أجله، عندما استعمل واحدة من الصيغ الطلبية هي صيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر الدالّة على الطلب لا بأصل الوضع، ولكن من التضام ما بين الفعل المضارع ولام الأمر، التي هي من أدوات الجهة في القرينة السياقيّة للدلالة على الزمن النحوي لا الصرفي، ومن هنا فقد كان دخول اللام على الفعل المضارع سبباً لدلالة الفعل المضارع على زمن الحال والاستقبال[254]، بعدما كان يدلّ على الزمن المستقبل قبل الالتضام مع اللام الطلبية، ولذا أفاد منه الخطاب الحسيني من أجل الدلالة على الزمن المستقبل القريب، وهو صباح الغد الذي هو موعد الرواح. ولكنّه طلب من النوع الثقيل الذي تنأى به الجبال الرواسي، فقد صيّر طلبه جملة شرطية تتضمّن وصفاً للذوات التي ينبغي أن تركب سفينة الالتحاق بالركب الحسيني؛ حتى يتسنّى لهم أن يكونوا أنصاراً وأعواناً لإمامهم الحسين×، وإذا كان الإمام الحسين×يسير إلى المصرع الذي هو لاقيه، فينبغي على مرافقيه أن يكونوا قد استشعروا حتميّة الموت المحقق الواقع لا محالة.
وضع الإمام×شروطاً خاصّة على مرافقيه، كي يتسنّى لهم شرف الرفقة معه، وهي بذل النفس والنفيس دونه؛ لأنّه وضّح بعض المعاني الكاشفة عن أنّه ممن ينبغي التضحية من أجله ـ قبل أن يعطي هذه الشروط ـ حينما قال: (رضا الله رضانا أهل البيت)؛ كي تعي الأمّة أنّ الطريق الحسيني يعني طريق اللهI؛ لأنّ الحسين× هو من مصاديق رضا اللهI، إن لم يكن كل المصداق الحقيقي لرضاهI في زمانه. كما قال: (من كان باذلاً)، للدلالة على وحدة المبدأ بين الخالق وبين مخلوقه الحسين×الذي يمثّل وجه اللهI الحقيقي في الأرض، أي: أنّ بذل المهج في الحسين× لا يعني بذلها لغير اللهI، بل هو البذل في اللهI؛ لأنّ الحسين×يسير وفق أمر اللهI، فلا اثنينيّة بين المبدأين الحسيني والإلهي، بدلالة قوله×: «موطّناً في لقاء الله نفسه»، المؤكِّد للمضمون نفسه الذي بدأ به؛ لأنّ لقاء اللهIالمرضي يمثّله الطريق الأوحدي لسيد الشهداء×في البذل النفسي والجسدي. وهذا هو التوظيف التداولي للخطاب الحسيني الموصل إلى اللهI، عندما اعتمد عليه الإمام×لكي يخبر عن الحقيقة التي يستبطنها مضمون كلامه، في كونه يسعى إلى تضحية معنوية تعبوية عظيمة، تكون من النوع الذي يترك بصماته على صفحات التاريخ حتى يكتب لها الدوام إلى ما شاء اللهI من السنين والقرون. ولكي يتحقق هذا الأمر لا بدّ أن تكون التضحية التي يريدها هي تضحية بالنخب والذوات التي تعي معنى الشهادة مطلقاً، ومعنى الشهادة مع الحسين× خاصّة، لا مع غيره ولا مع عدوّه. فكان الإمام لا يفتأ من التركيز على هذا المطلب، وذلك من خلال التوظيف الدقيق بين معنى الشهادة المطلقة وبين معناها مع الحسين×، أي: مع المبدأ المقدّس القائم على نكران الذات، وعدم الخضوع لسياسة الظالمين الممزوجة بالحيل والمكر والتخويف، إذ لا شبهة أنّ الإنسان الذي يستطيع الانتصار على نفسه الجموح، ويجعل روحه على راحتيه، ويلبّي دعوة الموت والشهادة من أجل العقيدة الإلهية؛ دفاعاً عن نور الوجود الإلهي المتجلّي بالحسين×، هو من النفائس الإنسانية التي هي أنفس من الكبريت الأحمر، كونه قد أرخص المهجة وزهد بها؛ كي يرضي إمامه المظلوم. وهذا ما أكّد عليه الإمام الحسين×من خلال توظيف الطابع الذاتي لرفقاء الرحلة الحسينية وترويضه، حتى يكونوا من الذوات التي تخضع للاختيار الانتقائي لشق مسيرة هذه النهضة النوعية، وهو مما لا يتناسب إلّا مع الكُمَّل من البشر. لذا لم يدخر الحسين×وسعاً، ولم يتوانَ عن التأكيد على أنّه مقدم على القتل والذبح في كل محطّة من محطّات خروجه حتى وصوله إلى كربلاء، قاصداً ـ بذلك ـ إعطاء الرخصة لكل من آثرت نفسه الحياة الدنيا، كي يعزف عن اللحاق بالحسين×، فلا يبقى معه إلّا من تعلّقت روحه بالمبدأ الحسيني المقدّس.
وقد اعتمد الإمام الحسين×على صيغ موحّدة في تحديد الصفات التي يريدها في أنصار الركب الحسيني وروّاده، وهي صيغ اسم الفاعل (باذل، موطّن، راحل) التي تعبّر عن الدلالة الزمنية في المستقبل؛ لأنّ اسم الفاعل ينبغي أن يدلّ على الزمن المستقبل كي يكون عاملاً، ولا شكّ في أنّ صيغتي اسمي الفاعل كانتا عاملتين في النصّ حين قال: (من كان باذلاً فينا مهجته)، إذ صيَّر كلمة (مهجته) مفعولاً به لصيغة (باذل) كما جعل كلمة (نفسه) معمولاً (مفعولاً به) لصيغة اسم الفاعل (موطّن) في قوله: (موطّناً للقاء الله نفسه)، لا سيما أنّ الصيغ كانت خاضعة لشرط المذهب البصري من حيث وجوب الاعتماد في الصيغ الاشتقاقية كي تكون عاملةً، إذ كانتا خبراً للفعل الماضي الناقص (كان) مما يستلزم الدلالة الاستقبالية التي يدلّ عليها اسم الفاعل في عمله؛ لأنّ الخطاب يستلزم رجاء التضحية مستقبلاً لمن يرغب بتلك التضحية التي تتناسب مع مضمون الخطاب الطالب للنصرة من أجل نهضة عظيمة ستقع بعد حين.
ولأنّ الإمام×يطلب النصرة والدعوة إلى الرحيل المميت، ما يستلزم استعمال تلك الصيغ التي تعبّر عن الدوام والثبوت مما يتناسب وطبيعة الأهداف النهضوية التي ذهب من أجلها، فالشخص المطلوب ـ كما تدلّ عليه صيغ اسم الفاعل ـ يجدر به أن يكون ثابت القدم، لا يتزلزل عند اللقاء وعند اصطكاك الأسنّة، وكما ذكرنا: إنّ هذه الصرامة في النصرة الحسينية عبّر عنها بصيغة اسم الفاعل بأجلى وأوضح صورة، لأنّ المسألة لا تحتمل التذبذب في الشخصية الناصرة للحسين×؛ بل يتعينّ تلبّسها بالثبات والرسوخ الذي تلبّست به شخصية إمامهم في اتخاذه للقرار النهائي، والعزم على مواصلة التحدّي للفكر الأموي، حين قال: (فإنّي راحل لا محالة)؛ لأنّ المصرع لا بدّ إذاً لاقيه، فلا مناص من الرحيل، وهي لا بُدِّية الصيغ الإسمية الدالّة على الدوام والثبوت، المتضمّنة معنى الجزم. فالفعل اللّغوي (راحل) استلزم ـ بوصفه من الصفات ـ الجزم بأنّ القرار صائر لا محالة، فالصفة تستلزم حتميّة الخروج المقيّد بالقرينة الحالية (مصبحاً)، وليس الإخبار فقط[255]، مما تؤكّده القرينة (صيغ اسم الفاعل) التي اعتمدها الخطاب على الزمن المستقبل، إذ أنّها من خلال الخطاب تدلّ على المستقبل المطلق غير المقيّد، فكان عليه أن يبيّن القيد الزمني الاستقبالي لموعد الرحيل؛ كي يضع السامعين أمام ما سيقدم عليه وجهاً لوجه.
وليس هذا فحسب، بل إنّ اسمي الفاعل لم يدلّا على الثبوت الإسمي المستفاد من الصيغة الاشتقاقية لكل من (باذل) و(موطّن) بوصفهما يدلّان على ذلك من خلال التركيب السياقي لهما، فهذا المعنى المقصود يمكن أن تستلزمه وتوضّحه الدلالة اللّغوية المعجمية للّفظة المفردة خارج نطاق التركيب اللّغوي النحوي[256]، أي: بواسطة المدلول الصرفي للّفظتين، وعليه يمكن استجلاء تلك المقاصد في ضوء المعطيات الآتية:
1ـ ذكر ابن منظور(ت711هـ) في توضيح المعنى المعجمي لكلمة (باذل) قوله: «كل ما طابت نفسه بإعطاء شيء فهو باذل له»[257]. أما المعنى المستلزم وهو ما قصده الإمام×؛ أي: البذل دون مقابل، فيمكن أن يُفسّر بأنّ الإمام× يخاطب الإرادة الإنسانية كي تنسلخ عن ذاتها لتنتقل من الأنا إلى الله تعالى [258]، وهذا الأمر لا يتحقق إلّا بإرادة الإنسان مع قناعة العقل بالتجرّد عن كل ما دون الله تعالى.
2ـ يشترط في هذا البذل أن يكون بذلاً للمهجة التي هي «دم القلب ولا بقاء للنفس بعدما تراق مهجتها»[259]، وليس بذلاً للمال أو غيره من مغريات الدنيا الفانية التي لا تعني شيئاً في الفكر الحسيني.
3ـ ينبغي أن يكون بذل المهجة بذلاً في محلّه؛ كي يعطي النتائج المتوخّاة، وليس له محلّ في هذه الدنيا سوى الحسين×، فالتقديم بالجار والمجرور (فينا)، الذي خرق نظام الملفوظات[260] استلزم منه أن يعطي السمة التعليلية لهذه التضحية، وهي الاختصاص ـ كما مرّ ـ من خلال إذكاء شعور الولاء والانتماء في روح الباذل، الذي هو انتماء بالدرجة الأساس، وليست الغاية التضحية، بل هي ابتغاء وجه اللهI[261]، إلا أنّه لا مانع من الجمع بين التضحية في الحسين×، والتضحية في اللهI، فهناك الكثير من الأدلّة النقلية التي تؤكّد وحدة المضمون، أي: وحدة النتائج المفضية بين الموت في الحسين×وبين رضا اللهI، من قبيل ما جاء في دعاء زيارة عاشوراء «اللهم أرزقني شفاعة الحسين يوم الورود، وثبّت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين، الذين بذلوا مهجهم دون الحسين×»[262]، فالخطاب يتضمّن ثبوت القدم عند اللهI تعالى، وهذه العبارة تعني أن القرب المعنوي لأصحاب الحسين×من الحسين×؛ بعدما بذلوا مهجهم دون إمام زمانهم، أهلهم للقرب من الله تعالى.
4ـ نتيجة الذب عن الإمام الحسين× وحرمه هي مرضاة الله تعالى، لذا تكون النتيجة واحدة بدلالة قولهتعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ)[263]، إذ يقول صاحب تفسير الميزان في (جاهدوا فينا): «استعارة كنائية عن كون جهده مبذولاً فيما يتعلّق به تعالى من اعتقاد وعمل، فلا ينصرف عن الإيمان به والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه بصارف يصرفه»[264].
وعن الإمام الباقر× في الآية الشريفة نفسها: «هذه الآية لآل محمّد وأشياعهم»[265]، فهذا يدلّ على وحدة المضمون بين التضحية في الحسين×والتضحية في اللهI، لأنّ النتائج واحدة، إذ كلّها تقود إلى رضاهIما دام «رضا الله رضانا أهل البيت». فلا قيمة للتضحية بهذا المعنى، ما لم تستمدّ جذورها ومباركتها وعنوانها التشريعي من البيت الطاهر.
5ـ حتى يبيّن الحسين×أنّ التضحية دون أهل بيت العصمة والطهارة ليست خارجة عن رضا اللهIأردف كلامه بضرورة أن يكون الباذل فيهم مهجته من الموطِّنين أنفسهم على لقاء اللهI، أما معنى التوطين، فقد جاء في لسان العرب: «وطّن نفسه على الشيء وله، فتوطّنت: حملها عليه فتحمّلت وذلّت له»[266]، وهذا التفسير اللّغوي ينسجم تماماً مع الدلالة النحوية لصيغة اسم الفاعل الدالة على الثبوت، ما يستلزم إنطواء صيغة الكلمة على قوّة وشحنٍ لغويّ يحكي أوصاف أنصار الحسين× ومريديه، بعد الإفادة من الدلالة الاصطلاحية لمفهوم التوطين الذي يعني «أعلى درجات الإعداد النفسي لمواجهة الابتلاء»[267]، فقد كان الحسين×يرفض أن يكون في صفوف جيشه أيّ فرد يعيش ضعفاً أو حرجاً في ارتباطه به؛ لذلك كان يخاطب مرافقيه مرخصاً لهم في تركه كلّما سنحت الفرصة لذلك[268]؛ لأنّ الإمام ×لم يكن محتاجاً للصحبة بمعناها المطلق؛ بل صحبة تدفع عنه القتل بسيوفها[269].
وهنا تجدر الإشارة إلى مسألة في غاية الأهمّية، كان قد تضمّنها الخطاب الحسيني، حيث يذهب الأصوليون إلى أنّ الجملة الشرطية تستلزم مفهوماً يستفاد من منطوقها اللّغوي ـ خاصة تلك التي ترد في السياق القرآني، أو في السنّة المطهّرة ـ مفاده أنّ الجملة يمكن أن يرد فيها مفهوم مغاير لما عليه السياق اللّغوي، يعرف في الدرس الأصولي بمفهوم الشرط، وهو المدلول السلبي للجملة الشرطية[270]، وقد وظّف الأصوليون هذه النظرية في توجيه النصوص الدينية التي تأتي على هيأة الجملة الشرطية. وفيما نحن فيه؛ نجد أنّ الجملة الشرطية في الخطاب الحسيني، توقّف فيها جواب الشرط الذي هو طلب الرحيل بمعية الركب الحسيني على ركيزتين، هما: بذل الأجساد، وتوطين النفوس للقاء اللهI، وهو المعنى القضوي للجملة الشرطية، الذي يمكن أن نستخلص منه مفهوماً يغاير السياق اللّغوي، والقصد المستلزم، الذي يستلزمه الخطاب الحسيني نفسه، وليس تجنّياً عليه، أو لياً لعنق الخطاب، بل هو استعمال دلالي مارسه الأصوليون[271]، وهو: من لم يكن باذلاً فينا مهجته، ولا موطّناً للقاء الله نفسه، فلا يرحل معنا، ما يعني أنّ الشرطين الذين استلزمهما الخطاب الحسيني، قيدان أساسيان في الحقيقة النوعية لشخصيات الرفقة في الركب الحسيني، تحصل الموافقة على الرحيل بوجودهما وتنتفي بانتفائهما.
تعدّ الاستعارة من أهم الأساليب البيانية، وأكثرها تأثيراً في النفس، وإرهافاً للحس، وعلامة هذا الاهتمام هو كثرتها في الكتاب الكريم والسنّة النبويّة والأدب العربي شعراً ونثراً وخطابة.
والاستعارة حسب تعبير الجاحظ: «تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه»[272]، وتعني عند عبد القاهر الجرجاني(ت474هـ) «أن يكون اللفظ أصلا في الوضع اللّغوي معروفا، تدلّ عليه الشواهد على أنّه اختصّ به حين وضع، ثمّ يستعمله الشاعر في غير ذلك الأصل»[273] أو يوضّحها بعبارة أدقّ «أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبّه به فتعيره المشبّه وتجريه عليه»[274]، وعند السكاكي «أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدّعياً دخول المشبّه في جنس المشبّه به، دالاً على ذلك بإثباتك للمشبّه ما يخصّ المشبّه به»[275] فتنزاح الدلالة فيها سالكة مساراً منحرفاً عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؛ على أنّها صورة تشبيهية حذف أحد طرفيها، فحينئذٍ تقفز من معنى اللفظ في أصل الوضع إلى معنى المعنى[276]، مفارقة الدلالة الحرفية للألفاظ مستخفة بالأعراف اللّغوية، بكل ما فيها من حذف لأداة التشبيه ووجه الشبه وأحد ركني التشبيه وانبنائها على ادعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به[277] لتخلق «واقعاً جديداً أكثر من تقنينها لما هو موجود سلفاً، وهذا الخلق يؤدي إلى إيجاد مشابهات جديدة، ناتجة عن بعض الخصائص التفاعلية المنتقاة»[278]، مضافاً إلى ما تنتجه من تداخل وامتزاج في طبيعة الحدود بين الماديات (من إنسان وحيوان) والمعنويات المختلفة[279]، وهذا من شأنه أن يثري الخطاب، ويعزّز التواصل بين المتكلّم والمتلقّي عبر قنوات الاتصال الفعّال.
ومن المقاصد التي ظهرت عبر خرق قاعدة الكيف على مستوى الاستعارة:
أولاً: ما جاء في خطاب الإمام الحسين× في مكّة بقوله: «...، كأنّي بأوصالي تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن منّي أكرشاً جوفى، وأجربةً سغباً»[280].
فقد عمد الإمام×إلى إظهار بشاعة المنظر الذي سيؤول إليه حاله على يد تلك العصابة المتوحّشة الفاسدة، فعمد إلى استعمال الصورة الاستعارية بعد أن تيقّن بشاعة الحدث، وأراد إثارته عند المتلقّي من خلال التفاعل مع الصورة في السياق والإيحاءات الناتجة عنها لإيصال المعنى المعبّر؛ لأنّ توكيد المعنى، أي: إيصاله إلى المتلقّي عن طريق المبالغة في إثبات تحقيق الصفة فيه، هو من أهمّ ما يقصد إليه المتكلّم في التصوير الاستعاري؛ من خلال استعارة لفظة أكثر تمكّناً في الدلالة على الصفة في اللفظة الأصلية، وتوظيفها بدلاً عنها في التعبير؛ للدلالة على ذلك المعنى مجازاً لعلاقةٍ تربط بينهما، وتصحّح مثل هذا الاستعمال، بحيث توحي للمتلقّي بأنّ طرفي الاستعارة انصهر بعضهما ببعض حتى أصبح المستعار له كأنّه المستعار منه، وهو ليس كذلك على نحو الحقيقة[281]، فالعلاقة بين (العُسلان) والجيش، وبين عقول تلك الذئاب البشرية والصحراء، هي «علاقة من صنع الخيال الذي يحاول أن يحدث التأثير في المواقف والدوافع عن طريق إذابة هذه العناصر وخلق الجديد منها»[282]وهذا بطبيعة الحال ليس خيال شاعر أو كاتب أو روائي، بل هو خيال إمام معصوم متأتٍ من واقع علمه اللدُني، وقد عمد إليه عن قصد، لانصهار كل من طرفي الاستعارة في بوتقة واحدة حتى تثير نبضات الإثارة، وتبعث الانجذاب في نفس المتلقّي، فاستعار لفظ عسلان من تلك الحقيقة الحيوانية لأفراد الجيش الحاقد المتأهّب لقتاله والمتعطّش لدمائه. ومع أنّه×لم يصرّح بالمستعار له إلّا أنّه يمكن أن يستنتج من الدلالة التاريخية[283]، ناهيك بأنّ (العسلان) حقيقة لا تسلّط على أوصال صفوة الله؛ لطفاً من الله وإيثاراً له[284].
عمد الإمام×إلى إظهار هذه الصورة المتمثّلة بتفاعل أفراد الجيش والذئاب بعضها مع بعض، تفاعلاً مميّزاً داخل سياق الكلام، إلى المتلقّين؛ ليكونوا على دراية واطلاع على وحشية القوم وشراستهم، وهذه الصفات ملازمة لتلك الحيوانات، فهو×تقصّد إيصال هذا المعنى الجامع بينهما، وبين المستعار له؛ فكلّما قوي الشبه بين الأصل والفرع، ازدادت الصورة الاستعارية حسناً وجمالاً[285]، كما أنّ الخرق الذي حصل نتيجة قفز الاستعارة على المعنى الحقيقي استخفافاً بمتواليات النظم، وتجاوزاً للمعنى الحرفي للملفوظات إلى انزياحات لغوية مجازية، من شأنه تقوية المعنى وإثارة العواطف في النفوس بما تقدّمه من عرض لـ«الصور والصفات والأعمال عرضاً حسّياً مجسّماً؛ ليرى القارئ في ألفاظها من الألوان والمعاني ما يراه إذا هو نظر إلى رسم وتبصّر في خيال»[286] من خلال:
1ـ المعنى الحرفي: وهو مباشرة الذئاب الصحراوية حقيقةً لتقطيع جسده الشريف.
2ـ القصد المستلزم: وهو ما اجتهد الإمام×في إيصاله للمتلقّي عبر هذه الأداة التصويرية التي لا يمكن إيصال مراده ـ في رسم حقيقة تلك النفوس المريضة التي امتلأت أحقاداً أموية ـ إلّا بها.
وقد سعى الإمام× إلى تأكيد حقيقة تلك الحيوانات من خلال حسن إطلاقه لكلمة (تقطّعها) وما أضفته من قوّة وشدّة، ولّدها التضعيف في حرف الطاء، فالزيادة في المبنى تؤدّي إلى زيادة في المعنى، ولعلّ هذا ما قصده الإمام×لما له من دلالة نفسية، تشير إلى شدّة قسوة الجيش، ووحشيّته وغلظته التي لا تحيد عنه، كما هي الحال مع الذئاب التي تنقضّ على فريستها، فتقطّعها وتمزّقها، فكذلك ستكون أوصاله أشلاءً متناثرة على رمضاء كربلاء، وهذه من شأنها أن تبعث أثراً عميقاً في النفس، وهزّة ترتعد منها الفرائص[287].
ويؤكّد هذا المعنى ـبمزيد من الوضوح والبيانـكلمة أنطوان بارا بقوله: «فالوحشية التي شهدتها كربلاء ليس لها شبيه حتى بين أشدّ الوحوش ضراوة، وكلمة الوحشية لا تفيها حقها من الدلالة عليها، فقد فاقت الوحشية بمراحل، وتقدّمت على الدموية بخطوات، وصار لزاماً أن يوجد لها تعبير يلائمها، لكنّ العقل البشري الذي وضع لكل مظهر حدوداً قصوى في الفعل والتعبير عن هذا الفعل...، لم يستطع تخطّي تعبير الوحشية والهمجية، مع أنّ الواقعة كانت تتخطّاهما بمراحل شاسعة»[288] بل تبعها عملية تقطيع أخرى، يمرّ بها المقتول بالسيف، ذلك لأنّ السيف ـكما هو معلومـلا يقطّع الأوصال، بل يقطّع الجسد إلى أوصال، فتكون الأوصال هي أبعاض الجسد المقطّع، وهذا هو الجو الطبيعي لمن يُقتل مقطّعاً بالسيف، إلّا أنّ الإمام×ذكر بأنّ تلك الوحوش البرّية لم تقطّع الجسد الطاهر للإمام× فحسب، بل عمدت إلى تقطيع آخر، هو تقطيع للأوصال التي هي بعض الجسد، ويزيد بشاعة هذه الصورة المأساوية أنّ الإمام×جاء بالفعل (تقطّع) بالتشديد؛ للدلالة على شدّة المبالغة التي ستمارس على جسده بعد قتله×، وهو إشارة إلى أنّ هذه الوحوش لم تكن تنوي قتله لتصل إلى مرادها فقط، بل كانت تنوي توزيع الجسد، وتقطيعه، وهذه الوحشية ـ قطعاً ـ لا تتحقق إلّا بعد موت صاحب الجسد؛ لأنّ تقطيع الأوصال هي مرحلة متأخّرة عن تقطيع جسده إلى أوصال، فيكون قد مات تقطيعاً إلى أوصال، فتأتي مرحلة تقطيع أوصال الجسد الميّت للكشف عن بشاعة هذه الصورة. ويعزّز هذه الصورة الاستعارية بصورة استعارية أخرى؛ لتكون أبلغ في إيصال قصده بقوله: «فيملأن منّي أكراشاً جوفا وأجربة سغباً»، فالعملية لا تقف عند حدود التقطيع والتناثر للأشلاء، بل تتبعها عملية تناول لتلك الأجساد الطاهرة، وملء لأكراش فارغة، وأجربة قد أهلكها الجوع، وهنا استعارة تصريحية، إذ لا توصف الأجربة بالجوع، بل استعارها للبطون الجائعة بجامع الفراغ، فكأنّها كيس فارغ، ليس فيها ما يسدّ رمقها، ولك أن تتصوّر الحالة التي تكون عليها حينما تنقضّ على فريستها.
وليس مراد الإمام× من جوع البطون وفراغها على نحو الدلالة الحقيقية، بل المستلزم من خرق القاعدة قصدٌ آخر، وهو توصيف أو تشبيه الحاجة النفسية أو الحاجة الدنيوية التي كانت لأعدائه من قتله والخلاص منه بأكرشة هذه الحيوانات وبطونها الجائعة[289].
ثانياً: تقف السيدة زينب‘ أمام يزيد في الشام لترسم في متوالية ملفوظاتها من الصور الاستعارية ما تستلزمه من مقاصد أدقّ وأعمق، يجعلها أكثر تأثيراً في المتلقّي، ومن ذلك قولُها: «وأنَّى يُرْتجى الخير مِمن لَفَظ فُوه أَكبادَ الشُّهداءِ، ونبتَ لحمُه بِدماء السُّعداء، وَنصبَ الحرب لسيّد الأنبياء»[290]، ففي هذا الخرق تستعير الخطيبة‘لفظة (فوه) لتستلزم منه قصد التذكير بما فعلته جدّته التي أخرجت كبد حمزة بن عبد المطلب& في معركة أُحد، ولاكت قطعة منه بسبب الحقد المُتأجّج في صدرها، والسيدة زينب‘ إنّما استحضرت في خطبتها هذه الصورة البيانيّة، بعد ما رأت يزيد ينكث ثنايا الحسين× بمخصرته؛ لتُقدّمه من خلالها لمن كان في حضرته على أنّه الوارث لجدّته في الحقد على الإسلام وآل الرسول^.
وفي خطاب آخر ترسم صورة تلوّح فيها إلى حقده الدّفين، بقولها: «وَضَبٌّ يُجَرْجَر في الصّدر لِقَتْلَى يَومِ بَدْر»[291]، يظهر فيها أنّ السيدة زينب‘ في هذا الاستعمال البياني تستعير فعلاً لغوياً (يُجَرْجَر) للضب، وهو الغيظ الكامن أو الحقد الخفي، لتعرب عن قصدها؛ وهو:
ـ فضح يزيد وبيان حقيقته، من خلال الحقد المُتأجّج في صدر يزيد وتُظْهِرَهُ لكل من في مجلسه. حيث بلغ به حقدُه المطالبة بثارات المقتولين في غزوة بدر، وهم أقطاب المشركين الذين خرجوا لمُحاربة الرسول’، ومع هذا يُريد الثأر ويَشْعُرُ بأنّ في قتلِهِ للإمام الحسين×ومن معه من آل البيت والصحابة^غايته التي تمنّى، فيستوفي بهذا الصنيع ثأره من الرسول’. كما وصفت السيدة زينب ‘ حالة يزيد حين رأى الرأس الشريف بقولها: «التمع السرور بوجهه»[292]، وهو تعبير شكّل صورة فنّية من هذا الخرق الاستعاري خلافاً للواقع الذي تقتضيه الدلالة الحرفية من معنى؛ إذ أنّ السرور لا يلمع، ولكنّها‘استعارت لفظة (التمع) لتُبيّن من خلال هذه الاستعارة المكنيّة شدّة حقد يزيد وضغينته، لدرجة أنّ شدّة السرور الذي بان على وجهه حتّى تدفّق الدّم في وجنتيه، دفعه لضرب ثنايا الرأس الشريف للإمام الحسين×. وهي في كل ذلك قاصدةفضح يزيد أمام الملأ، وهو ما حدا بها أن تُشكِّل صورة بيانية هي غاية في القوّة والتأثير عبر هذا الخرق الحواري، بقولها: «مع أنّي ـوالله ـ يا عدوّ الله وابن عدوّه، استصغر قدرك، واستعظم تقريعك، غير أنّ العيون عبرى والصدور حرّى»[293]، إذ عبّرت عن قصدها الذي من أجله خاطبت يزيد، ووقفت أمامه ذلك الموقف التأريخي، فتولّد عن قولها هذا جملة من المعاني [294]:
أ ـ المعنى القضوي: المعنى الحرفي للملفوظات، والذي أرادت منه استحقار يزيد واستكثار التقريع فيه.
ب ـ القصد المستلزم: مع أنّك ـ يا يزيدـغير مستحق لخطابي، الّا أنّ قصدي ليس احتمال اتّعاظك، إنّما أروم ذلك في من غُرِّر بهم، وهم غيرك. كما أن في خطابها ردّة فعلٍ طبيعية لما شاهدته منه، وبذلك جاءت هذه الخروقات عبر قاعدة الكيف المتمثّلة بالصور الاستعاريّة، لتفنّد محاولاته في الخديعة والتضليل.
وإلى مثل هذا قصدت السيدة زينب‘ كواحدة من أفراد المسيرة الحسينية، على الرغم من الحالة النفسيّة التي سبّبتها لها مرارة فقد أخوتها وأهل بيتها، وكذلك هضمها لتلك الحالة بعد قتل الحسين×وأهل بيته، وحين لم يبق معها حمي ولا وليّ، سوى النساء والأطفال والعليل×. فوقفت أبيّة الضيم بوجه يزيد بن معاوية، موظّفةً ما تغذّته من بلاغة أبيها وأمّها÷وحسن بيانهما، فجاءت خطبتها مزيّنة بالصور الاستعارية، ومنها قولها: «فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، وهذه الأفواه تتحلّب من لحومنا، وتلك الجثث الزواكي تنتابها عسلان الفلوات»[295]: النطف: التلطّخ بالعيب، نَطِفَ الرجل ـبالكسرـإذا اتُّهم بريبةٍ[296]، (تنطف أكفّهم من دمائنا) أي: تقطر، أو تبل بالعيب.
وهذه استعارة راقية أرادت السيدة‘إنقداح صورتها في أذهان الحاضرين، مفادها أنّ هذه الأيدي قد بُلّت وتلطّخت بدماء أهل بيت رسول الله’، التي يدّعي يزيد أنّها تضرب بالسيف وبالرماح لأجل نصرة الإسلام وإعلاء كلمة (لا اله إلّا الله)، بينما على عكس ذلك، جاءت أكفّهم وسيوفهم تقطر من دماء أولئك السادة الأشراف.
وأخذت‘تتابع الخرق في هذه القاعدة؛ لما لها من تأثير في إيصال مرادها المتمثّل في رسم الصورة المأساوية، وما تحمله من وحشية وقساوة وغلظة، عبر خرق قواعد الحوار مجازياً بقولها «وتلك الأفواه تتحلّب من لحومنا» يُقال: حلب فلان الشاة أو النّاقة، أي: استخرج ما في ضرعها من اللبن، واستحلب اللبن أي: استدرّه[297]. حيث قصدت‘أن تشبّههم بولد الناقة، فكما أنّ ولد الناقة تتحلّب وتمتصّ بفمها الحليب من محالب أمّها، كذلك كان الأعداء يمتصّون بأفواههم من لحوم آل الرسول ودمائهم^، مصّاً قويّاً بدافع الحقد والبغضاء.
وعليه؛ يكون السبب من إطلاق التعبير الاستعاري «وتلك الأفواه تتحلّب من لحومنا» هو يقين السيدة‘ بأنّ المتلقّي يستطيع فهم المعنى غير الحرفي، وهو التعبير عن شدّة حقدهم وعدائهم[298]. فجاء خطابها استثماراً ـ لخرق قاعدة الكيف ـ أفادت منه من قول أبيها أمير المؤمنين×: «وإنّي لآنس بالموت من الطفل بثدي أمّه»[299]؛ ما يفيد أنّ الطفل عند المحالب يعيش سعادة التثام الثدي، فلا تعدل هذه السعادة عنده شيئاً، فضلاً عن شراهة الامتصاص التي يمرّ بها حين يُعطى الثدي وهو جائع. نفس هذه الصورة حين تنقلب في سياقها السلبي؛ نجدها تحكي السعادة المطلقة لقتلة سبط النبي×، وهم يقدمون على قتله بقلوب متوحّشة، لا تعرف معنى الرحمة، ناهيك أنّ المعنى المرتسم للشراهة من صورة (الاحتلاب) حتى تعطي بُعدها التمثيلي، يتكأ على المزاوجة بين هاتين الصورتين؛ أي بمعناهما السلبي والايجابي.
ومن الصور الاستعارية التي جاءت في خطابات المسيرة الحسينية، هو قول الإمام الحسين×معبّراً عن الدنيا بقوله: «إنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت، وأدبر معروفها، واستمرت حذاء، فلم يبق منها إلّا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل»[300] فقد شبّه الدنيا بأنّها صبابة، والصبابة هي كما يقوله الخليل: «ما فضل في أصل إناء من شراب»[301]، وهي استعارة تحمل شحناً بلاغياً، استلزمت توهين الدنيا وتحقيرها في ذهن المتلقّي، من خلال الإشارة إلى أنّ المتبقّي منها هو النزر اليسير من الشراب غير المرغوب فيه، والذي تنأى النفوس عن تناوله، كما وصف العيش بالخسّة لحقارته، فالخسيس أي: الحقير، يقال: خسّ الرجل نفسه وأخسّ، إذا أتى بفعل خسيس[302]. ومع أنّ الإمام وصف العيش بالحقارة لقلّته، إلّا أنّه أبلغ في توهينه ليتلقاه المتلقّي بصورته الصاغرة؛ لكي يعرف حجم ما يقتتل دونه. فاستعار له مرعىً وبيلاً، أي: مع كونه حقيراً إلّا أنّه يشبه مكان عيش للدواب، وهذا المرعى وخيم وثقيل، فالمستعار ـ هنا ـ المرعى الوبيل، والمستعار له الدنيا الخسيسة، أو العيش الذي يتمناه القوم ويقاتلون لأجله.
استعار الإمام× (للدنيا) ـوهي أمر معنويـألفاظاً تفيد التشخيص لتقريب الصورة، من قبيل: (تنكّرت، تغيّرت، أدبرت) وهي كلّها صفات لأهلها الذين سرعان ما يتنكّرون للمعروف، وينقلبون بعضهم على بعض؛ فهم بين مقبل ومدبر. بل لعلّ الإمام× قصد إيصال تلك الصورة المرتكزة في الأذهان عن الدنيا التي توشّحت وشاح المرأة وتنكّرت للمعروف، فهي متلوّنة متغيّرة، حيث ذكر في موضع آخر بأنّها «متصرّفة بأهلها من حال إلى حال، فالمغرور من غرّته، والشقي من فتنته، فلا تغرّنّكم هذه الدنيا...»[303]، إذ يبدو أنّ الإمام×كان يروم عبر هذه الصورة الاستعارية ملامسة معنى المعنى كما يسمّيه الجرجاني، أو القصد المستلزم، كما هي الحال عند غرايس، فالمتلقّي للخطاب أمام أكثر من معنى:
أ ـ المعنى القضوي: ظاهر كلام الإمام× هو تحقير الدنيا في عين المتلقّي.
ب ـ القصد المستلزم: يمكن أن يُلتمس ما استبطنته الصورة التي من أجلها سيق الخطاب، وهي أنّ الكلام يقتضي دعوة غير مباشرة منه×إلى الوقوف للقاء الله تعالى بعد مقت الدنيا وما فيها، لاسيما أنّه العروة الوثقى ـوهو الحقّـالوحيدة في زمانه التي من شأنها ايصال التوّاقين إلى لقاء الله ورضاه.
وفي استعارة للفعل اللّغوي (ترحض) تخرق العقيلة زينب‘ هذه القاعدة مخاطبة أهل الكوفة، بقولها: «ومُنيتُمْ بِشَنارِها، وَلنْ تَرْحضُوها أَبداً، وأنّى تَرْحضُون قتلَ سَلِيلِ خاتَمِ النبُوَّة، ومعْدِنِ الرسَالة»[304]، حيث يلحظ أنّ مسوّغ الخرق عبر هذه الاستعارة ما يلي:
ـ إظهار رغبة أهل الكوفة في التخلُّص من الذّنب.
ـ التعجّبت من القوم، واستنكار شدّة بكائهم.
مفاد استنكار العقيلة زينب‘ هو استسهالهم هذا الذنب (الرحض)، وهو فعل يتناسب مع الذنب الذي هو الدّرن، والذي لا يمكن أن يذهبه الاغتسال، ومن هنا خرج الخرق إلى مقاصد منها:
ـ أن تُقرّب‘ المعنى الذِّهني للعار والتلبُّس بالخطيئة إلى واقع الإدراك الحسّي عبر استعارة (الرحض) للغسل[305]، فصار القتل وصمة ولَطْخَة، لا يمكنهم التخلّص منها، فضلا عن أنّ ما يجعل جريمتهم مضاعفة هو تعلّقها بأعناقهم، حتى انقدحت في أذهانهم الصورة الواضحة لمعنى العار حين صوّرته الاستعارة المكنيّة بالوصمة واللَّطْخَة.
ـ أن تقصد‘ إشعال ضميرهم من خلال الشعور بالذنب، فاستلزم كلامها شعورهم بالعجز والحيرة، بين ما يتمنّون(من سهولة التخلُّص) ويفكّرون به (الرَّحض) واستحالة تحقيقه (أنّى ترحضون)، أي: كيف وبأيّ وجه تُبرّرون قتل سليل النبوّة؟! فمن خلال الاستفهام الذي خرج من دلالته ومعناه الحقيقي إلى قصد مجازي، وهو الاستنكار المُتلبِّس بحلة الاستعارة الدقيقة، ثمّ تعدّى الإنكار إلى الاستحالة، لم يَعُدْ أمامهم مجال للاعتذار عن ارتكاب مثل هذه الجريمة، فالرحض الذي فعلوه لا يُغسل؛ لأنّ الإمام الحسين×امتدادٌ للرّسالة، وذلك ليس بمجهولٍ عليهم.
وهي نوع من أنواع المجاز والاتساع في القول والانزياح باللفظ عن الظاهر[306]، أي: «أن يُعبّر عن شيء معيّن، لفظاً كان أو معنى، بلفظ غير صريح في الدلالة عليه»[307]. وقد حدّها الجرجاني بقوله: «أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليه»[308]، فالكناية ضدّ التصريح يؤتى بها إمّا للإبهام على بعض السامعين، كقولك: جاءني فلان، وأنت تريد: زيداً، وقال فلان: كيت وكيت، إبهاماً على بعض من يسمع، وإمّا لشناعة المعبّر عنه، وإمّا اختصاراً كالضمائر الراجعة إلى متقدّم، أو فصاحة، مثل: كثير الرماد لكثير القرى، أو لغير ذلك من الأغراض[309]، ولكنّها من حيث البلاغة أبلغ من التصريح، مما جعل «العرب تُقدم عليها؛ توسّعاً واقتداراً واختصاراً، ثقة بفهم المُخَاطَب»[310].
وبقصد السيدة زينب‘ الإشارة إلى الأصل العقدي الثالث والرابع (النبوّة والإمامة)، كنّت في خُطبتها أمام أهل الكوفة، بقولها: «قَتْلَ سَلِيلِ خاتَمِ النبوَّة، ومعْدِنِ الرسَالة، وسَيّد شَبابِ أَهلِ الجـنَّـة»[311]، وهي بهذا الخرق تُظهر مقام النبي’ على سائر الأنبياء، عامدة من خلال هاتين الكنايتين إضفاء الدلالة الخاصة لكلمة سليل التي أُضِيفَت إليهما الدلالة التي تراها لذلك السليل، إذ أنّها لا تقتصر على السلالة النسبيّة، بل هي سُلالة عقديّة إيمانية، وانتماء إلى أرقى ما في النبوّة من معنى. وقد أتت‘بهذا الخرق الكنائي الذي تمثّل بجُملة (سيّد شباب أهل الجنّة) وعطفتها على (سليل خاتم النبوّة)، لإبلاغ حجّتها[312]؛ إذ «من البصر بالحجّة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذ كان الإفصاح أوعر طريقة، وربّما كان الإضراب عنها صفحاً أبلغ في الدرك وأحقّ بالنظر»[313]، فكانت مقاصدها:
1ـ تقديم مظلومية الإمام الحسين× ومقامه عند ربّ العالمين، وليس لتخبر وتذكّر برأي الرسول’ فيه×فحسب؛ فالمعنى الحرفي لـ(سيّد شباب أهل الجنّة) هو الدلالة الحرفية للألفاظ، وهي الإخبار والتذكير، أمّا المعنى المستلزم أو المقصود فهو التشنيع بفداحة الجريمة التي ارتكبوها بحقّ ابن بنت رسول الله وبسيّد شباب أهل الجنّة، وهذا مقام إلهي لن يناله أحد غيرهما.
2ـ تولّد إضاءة جديدة عبر كناية (سليل خاتم النبوّة)، مفادها التميّؤ في هذه الرابطة المعنوية؛ والقصد من ذلك:
المعنى القضوي: هو الدلالة الحرفية لمتوالية النظم وهي الإخبار.
القصد المستلزم: وهو ما لم يدرك من الفعل اللّغوي المباشر الذي دلّت عليه القرائن من أنّ السيدة‘ قصدت بقولها: (سليل) للإيماء إلى عصمة الإمام×، وبيان مقامه من هذا الأصل العقدي الذي تجسّد فيه، وهو الإمامة، ولكنّه يدرك بالنظر والتفكّر، عن طريق إعمال الفكر. ومع علمها أنّه لا معنى للتمدّح والثناء بظاهر ما يدلّ عليه اللفظ من قرب الإمام من النبي (صلوات الله عليهما)؛ لمعرفة القوم جيداً بذلك، مما يستلزم من المتلقّي أن يطلب تأويلاً له؛ ليصل إلى مراد السيدة‘، يرجّحأنّها أرادت بـ(سليل) خلاصة عصمة جميع الأنبياء، بل خلاصة خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، بدليل قوله تعالى (مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ)[314]، أي: من الصفو الذي يُسل من الطين[315]. مُمَهّدةً بذلك للحديث عن صورة الإمام×، فحين «أقدمتم على قتله وانتهاك حرمته» ـ تخاطب أهل الكوفة ـ إنّما أقدمتم على انتهاك حقيقة الإمام الحسين× ببُعدها الأخروي والدنيوي، عبر سلسلة من أسماء المكان المُضافة إلى القضايا الأساسية التي كانت تشغل أذهان الكوفيّين[316].
ومن أجلى صور هذا النوع من الخرق هو خطبة السيدة‘، التي توشّحت بهذا اللون الرائع من البديع في قولها: «أمن العدل ـيا ابن الطلقاءـتخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا...، يتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد، والدنيّ والشريف»[317]، حيث قابلت وطابقت بينجملة من الصفات والأفعال، وقد سبق هذه المطابقة استفهام ونداء وصفة خرجت عن معناه الحرفي؛ إذ لا يخفى عنها‘حقيقة يزيد والبيت الأموي، وهو ما استلزم الاستنكار والتوبيخ، ومن ثمّ إقناع المتلقّي بالاتّكاء على هذا اللون البديعي في تقريب الصورة من الأذهان، وفضح يزيد أمام نفسه والحاضرين. فمسوّغات الخرق هذا هي نفسها التي تبيّنها القارئ في هذا المبحث؛ لأنّ سياق الموقف المقامي والظروف التي أُنتج فيها الخطاب واحدة، وقد ترشّحت من هذا الخرق المركّب الذي تشكّل من الاستفهام والنداء والصفة (الطلقاء) جملة من المقاصد، منها:
1ـ الإشارة إلى موقف النبي الأكرم’، حينما استوت له الأمور، ومكّنه الله من رقاب المشركين بعد فتح مكّة، وصارت تحت سلطته، حيثكانبإمكانه أن يقتلهم بسبب مواقفهم العدائية، إلّا أنّه التفت إليهم قائلاً: «يا معشر قريش، ما تظنّون أنّي فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، أخٌ كريم، وابن أخٍ كريم، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء»[318].
ولعلّ السيدة‘ قصدت من هذه الصفة الكنائية أحد المعنيين أو كليهما:
المعنى الأوّل: أن تذكِّر يزيد وتُفهِّم المجلس بأنّه (يزيد) ابن الطليقين اللذين أطلقهما رسول الله’ مع أهل مكّة وكأنّهم عبيد، فتكون الكلمة تذكيراً له وفضحاً أمام وزرائه ووجهاء الشام، بسوء سوابقه المخزية، وتاريخ جدّه وأبيه المزري[319].
المعنى الثاني: أن تذكِّر يزيد بالإحسان الذي أغدق به عليهم رسول الله’، مستنكرة بذلك أن يكون ردّ الجميل والمعروف بما جرى عليهم؛ أي: أوليست مفارقة بأن يُتعامل مع بنات الطهر والعفاف بنات رسول الله’ بهذه الطريقة المشينة؟!
2ـ توبيخ يزيد على سلوكه الفظ وأخلاقه المنحطّة، وابتعاده عن أولويات الفطرة البشرية، التي تقضي بأن جزاء الإحسان بالإحسان.
3ـ الطعن في عدالة يزيد أمام مجلسه، إذ لا يُرجى منه عدل، مع أنّه حينما ادّعى الخلافة لنفسه والإمرة على المؤمنين، يُفترض به أن يكون عادلاً.
الاستلزام الحواري في ضوء قاعدة الملاءمة
احترام قاعدة الملاءمة
احترام قاعدة الملاءمة (العلاقة أو الصلة): وهي من أهمّ مبادئ الحوار وأحكامه، التي تكتمل وتتمّ بها عملية التواصل التخاطبي، وقد اعتمدها كثير من التداوليين كأساس تنطلق منه بقيّة القواعد، وأشهرهم "الصِلَويُّون" أصحاب نظرية الصلة[320] أو المناسبة. وهي قاعدة يتوافق فيها كل من المقال والمقام، لإبلاغ قصد المتكلّم بأنسب الطرق.
وتعني أن يكون الكلام مناسباً، له صلة بموضوع الحوار، أي: يأتي التخاطب مطابقاً لمقتضى حال المقام الذي قيل فيه من حيث الظروف والملابسات ذات العلاقة التداولية بموضوع الخطاب، وقد ذكر المتقدّمون من علماء البلاغة هذا الأنموذج التخاطبي في تعريفهم البلاغة، حين أخذوا هذا المعطى التداولي قيداً وشرطاً في صحّة بلاغة الخطاب وهو لكل مقام مقال[321]، فلا يكون الخطاب بليغاً بغيره.
ولقاعدة الملاءمة السبق على (الكم، والكيف، والطريقة) فيما تقدّمه من استلزامات كثيرة، فباحترامها والتقيّد بها من المتكلّم، تستطيع أن تعطيه القدر الأكبر ـ أكثر من أيّ قاعدة ـ من الإيجاز وعدم الإطناب في الخطاب، وترك الأمور التي من شأنها حرف مسار التواصل، إذ «إنّ قائل اللغة العادية ـوهو على وعي بقواها المشتقّة من دلالاتها الكامنة في العلاقاتـلا يفتأ ينزل هذه القوى على حكم المعايير والأغراض العلمية التي يستوجبها الموقف المعيّن»[322]فيقدّم خطاباً ناضجاً ملائماً للمناسبة التي صيغ فيها بقصد الإفادة.
ولذا قد يتباين تفاعل المتكلّم في المواقف الخطابية ـ بحسب المقام ـ فأحياناً يتمثّل المعنى تامّاً، فيفهمه المتلقّي من المحتوى القضوي بكل سهولة ووضوح، وأحياناً أُخر قد يلجأ منتج الخطاب إلى إبهام القصد وإخفائه ـ لغرض ما ـ فيظهر الخطاب كأنّه لا يتلاءم مع مجريات المقام، وهنا يصبح المتكلّم خارقاً لمبدأ المناسبة، وعند الإمعان فيه تجده ـ على وفق قواعد التحاور الغرايسية ـ مناسباً للمقام، غير أنّ منتجه أخفى قصده بالخرق؛ ليوصل رسالته بأسلوب مختلف عن المعهود. ولذا من العسير جدّاً العثور على نماذج يحصل فيها استلزام عن خرق حقيقيٍ لقواعد هذه المقولة؛ إذ أنّه من النادر تقديم جواب لا يمكن اعتباره غير ملائم بالنسبة إلى سياق ما[323].
ويمكن أن نقارب ـتداولياًـهذه القاعدة مع الاستلزام الحاصل في المحاورات التخاطبية في خطاب المسيرة من خلا ل وضوح الألفاظ:
إغتنم الإمام×في فرصة حواريته مع الوليد بن عتبة[324]عامل بني أمية على المدينة، المأمور بأخذ البعية من الإمام ليزيد[325]، حيث كان مروان بن الحكم[326] حاضراً، الحثّ على إصلاح ذات البين، فقال: «الصلة خيرٌ من القطيعة، والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا، أصلح الله ذات بينكما».
ـ الوليد ومروان، لم يجيباه بشيء، وقد علاهما صمت رهيب!
ـ الإمام ـبعد أن سأل الوليد عن حال معاوية، وأخبره بوفاتهـقال للوليد: لماذا دعوتني؟
ـ الوليد: دعوتك للبيعة.
ـ الحسين×: «إنّ مثلي لا يبايع سرّاً، ولا يجتزأُ بها منّي سرّاً، فإذا خرجت إلى النّاس ودعوتهم للبيعة دعوتنا معهم، كان الأمر واحداً»[327].
ـ الوليد، شكر الإمام الحسين× على مقالته، وسمح له بالانصراف إلى داره بعد أن توهّم الموافقة وطلب التأجيل، فقد عُرف عن الوليد طلب العافية ـكما يقول المؤرّخونـ[328].
ـ مروان: لئن فارقك الساعة ولم يبايع، لا قدرت منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، احبسه، فإن بايع وإلّا ضربت عنقه.
ـ الإمام الحسين×: «يا ابن الزرقاء، أَأَنت تقتلني أم هوَ؟ كذبت والله ولؤمت»[329] ثم أقبل على الوليد، فأخبره عن عزمه وتصميمه على رفض البيعة ليزيد، بقوله×: «يا أمير، إنّا أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، ومحلّ الرحمة، بنا فتح وبنا ختم، ويزيد فاسق فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمة، معلن بالفسوق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أيّنا أحقّ بالبيعة والخلافة»[330].
وهكذا تتجلّى مقاصد الإمام× في ضوء مجريات الحوار وتنوّع الأساليب[331]، فتكون على النحو الآتي:
الأسلوب الأوّل: ابتدأ الإمام×حين دخوله بأسلوب اتّسم بالهدوء والسكينة، حيث كان يناسب حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح ذات البين؛ فقال: «الصلة خيرٌ من القطيعة، والصلح خير من الفساد، وقد آن لكما أن تجتمعا، أصلح الله ذات بينكما»؛ أي: اغتنم الإمام×الفرصة لدعوتهما للإصلاح، ونبذ الفرقة والقطيعة، ودعا لهما بتمام ذلك، وبقي هذا الهدوء حتى بعد أن سمع الإمام سبب استقدامه في هذا الوقت المتأخّر من الليل، وهو أخذ البيعة. فرفضها بأسلوب راقٍ وبكلّ ثقة، قائلا: «إنّ مثلي لا يبايع سرّاً، ولا يجتزأُ بها منّي سرّاً، فإذا خرجت إلى النّاس ودعوتهم للبيعة دعوتنا معهم، كان الأمر واحداً».
الأسلوب الثاني: تحوّل أسلوب الحوار من المناورة والاستمهال وتأجيل الأمور والدفع بالتي هي أحسن إلى التشنّج والمواجهة والتحدّي، وهو ما اقتضته طبيعة التفاعل في مقتضيات المقام بعدما تدخّل مروان بن الحكم، وأنّب الوليد بقوله: (لئن فارقك الساعة، ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها...، احبسه، فإن بايع، وإلّا ضربت عنقه). فأجابه الوليد الذي كان أكثر منه حنكة وورعاً، وكان ينأى بنفسه عن التورّط بدم الحسين×لعلمه بمنزلته، وتتجلّى حكمته بردّ مروان، قائلاً: «ويحك، إنّك أشرت عليّ بذهاب ديني ودنياي، ـ والله ـ ما أحبّ أن أملك الدنيا بأسرها وأنّي قتلت حسيناً ـسبحان اللهـأقتل حسيناً لما أن قال لا أبايع، ـواللهـما أظنّ أحداً يلقى الله بدم الحسين إلّا وهو خفيف الميزان، لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ولا يزكّيه، وله عذاب أليم»[332].
وهنا وثب أبيّ الضيم على مروان بصوت واثق، وإيمان راسخ، يعرّض به، ويستنكر تهديده إيّاه بالقتل لوضاعته وحقارته، قائلاً×: «يا ابن الزرقاء، أَأَنت تقتلني أم هوَ؟ كذبت ـواللهـولؤمت»[333]وهنا حصل الخرق في إحدى قواعد الخطاب وهي قاعدة التأدّب[334]، بمناداة مروان (يا ابن الزرقاء)، إلّا أنّ هذا الخرق جاء ملائماً ومحترماً لظروف المقام، بعد أن تجاوز مروان بن الحكم على مقام الإمام×بقوله: «احبسه فإن بايع وإلّا ضربت عنقه»، وفي قول الإمام الحسين×: (يا ابن الزرقاء) كناية وتعريض بعدم طهارة مولد مروان وبيئته التي نشأ بها، وقد استلزم هذا الخرق قصد المتكلّم، وهو الاستنكار والتعجيز عن الإقدام عبر تشكيكه بمقدرتهما على ذلك، فمن كانت هذه حقيقته فهو جبان وعاجز، وما رشّح هذا المعنى هو الفعل اللّغوي المباشر (كذبت...، ولؤمت) والقسم (والله)[335].
الأسلوب الثالث: وهو رجوع الإمام×إلى حالة الاستقرار والهدوء مع الوليد بما يتناسب مع وضع الوليد، الذي كان مجبراً من قبل السلطة على انتزاع البيعة من الإمام×، حيث كان على علم بمكانته ومنزلته، وعلى يقين من موقفه من بيعة يزيد، فأراد من استدعائه للإمام×تمثيلية شكلّية، سببها:
الأوّل: أمر يزيد للوليد الذي كان واليه على المدينة، والثاني: وجود مروان بن الحكم، الذي كان حاقداً وحانقاً على أهل البيت^ وعلى الحسين×. وهو ما يفسّر قبول الوليد لكلام الإمام× ـ الذي تعمّد فيه الإمام إيهام الوليد ـ فسمح له بالانصراف، وشكره كما تبيّن. وبالتالي جاء كلام الإمام×مناسباً للموقف، ولم يعمد الرفض المباشر لطلب الوليد في بداية الأمر، من غير التأثير في موقفه الثابت، فقد كان واحداً في جميع المستويات، حيث لجأ إلى الكناية وعدم التصريح بقوله (مثلي لا يعطي بيعته سرّاً...) وعاد إلى مثل أسلوبه الأوّل مع نفس المخاطب (الوليد) بالرغم من حزمه وشدّته ـ الذي كان مناسباً ـ مع موقف مروان، حتى أنّ الإمام×خاطبه بكلمة (يا أمير، إنّا... ) فالإمام× قدّر وراعى ـ وهذا ما يُلمس في الأسلوب الأوّل والأسلوب الأخير من المحاورة ـ نوع المخاطب في حواره أثناء توجيه الخطاب، بما يتلاءم مع مجريات المقام، وتحصيل الفائدة، وبلوغ المراد، وهذه المراعاة تسمّى اليوم بتعديل القوّة الإنجازية على وفق مقتضيات المقام التخاطبي، وطبيعة المخاطب كما يحلو للتداوليين تسميتها[336]، فالمتكلّم يوازن ويعدّل منطوقه، أو يكيّفه تبعاً لمقصده في سياق اتصالي معيّن[337]، فيلجأ المتكلّم إلى تلطيف الخطاب وتليينه مرّة، والشدّة والحزم مرّة أخرى، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التحدّي والإنذار يباين مقام الهزل[338]؛ فلكلّ كلمة مقام مع ما يسانخها، ولكلّ حدّ ينتهي إليه الكلام مقام، وبهذا يتعانق المعنى وجزئيات التركيب في مواطن الاستعمال، كما يرتبط مع ما يبيّن تلك الجزئيات من علاقات خلقها المقام[[339]].
وكل ما جرى من تنوّع في أسلوب الإمام×الذي لم يجرِ على وتيرة واحدة، وإنّما تنوّع تبعاً لتنوّع المقام، وعلى وفق ما نصّت عليه حكمة العلاقة أو المناسبة من أن يكون الكلام ذا علاقة مناسبة بموضوع الخطاب، وعلى فرض أنّ المتكلّم كان ملتزماً بمبدأ التعاون، هو الذي يجعله يتحرّى الدقّة والإيجاز والابتعاد عن كل ما هو خارج عن الموضوع من أجل وضوح القصد.
ثانياً: خطاب سيّدنا العبّاس× محدّثاً نفسه
وذلك بقوله حين وصل المشرعة:
|
يا نفسُ من بعد الحسين هوني |
ممّا يجعل المتلقّي للخطاب يستلزم مقصدين:
1ـ أنّ العبّاس قد صيّر أخاه الحسين×ديناً له يحقّ له أن يُقتل دونه، وأن يذوق فيه مرارة السيف والعطش، فالتلذّذ بالماء وارتواء النفس عند العبّاس× مخالف لمبادئ السماء وقيمها.
2ـ أنّ هذه الأرجوزة من شأنها أن تكون دليلاً على توطين النفس التي أشار إليها الإمام×أوّل خروجه، والرابطة الوثيقة بين النهضة الحسينية وكونها هي الطريق الفريدة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ثمَّ فهي تعبير عن وحدة الطريق بين الحسين× وبين الدين.
ومنه قوله× حينما قطعوا يمينه:
|
والله إن قطعتمُ يميني |
فجاءت هذه الأبيات مستلزمة الإصرار على التفاني والاستشهاد، ومبرزة للشعور الديني الذي يدافع من أجله العبّاس×. حيث اختزل هذا الدين العظيم بشخص الحسين×؛ لذلك صار لزاماً شرعيّاً ودينيّاً أن يموت، وتقطّع أوصاله الطاهرة في سبيل القضية الحسينية، فالنصرة لديه لم تستجب لنداء الأخوّة النسبية بينه وبين الحسين×، بل كانت تلبّي نداء الدين الحنيف المتجسّد في شخص الحسين×، وكل هذه الألفاظ والمقاصد التي خرجت لها جاءت مناسبة لنداء الحسين×الذي لم يختزل بزمان ومكان معين.
ثالثاً: خطاب برير بن خضير لأهل الكوفة
«يا هؤلاء، اتّقوا الله، فإنّ ثقل محمّد قد أصبح بين أظهركم، هؤلاء ذرّيّته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم، وما الذي تريدون أن تصنعوا بهم؟ فقالوا: نريد أن نمكّن منهم الأمير عبيد الله بن زياد، فيرى رأيه فيهم»[342].
وهنا ينبغي الوقوف على الظروف التي كانت وراء هذا الخطاب؛ لكي تكون قرينة حاليّة مقاميّة تسهم في توضيح فحوى الخطاب ومؤدّاه، فيعرف حينها أنّ الباثّ لم يخرق قاعدة المناسبة، وأهم تلك القرائن:
ـ الخطاب صدر في العاشر من المحرّم، وكان موجّهاً لأهل الكوفة.
ـ كان أهل الكوفة عازمين على قتل الحسين×، أو تسليمه لأميرهم، كما صرّحوا بذلك.
ـ الباثّ كان من عُبّاد الكوفة وزهّادها، ولعلّ هذا ما يتناسب مع قوله (اتقوا الله) لأنّه لو لم يكن تقيّاً لكان كاذباً بقوله هذا، فيخرق حينها قاعدة الكيف، المفترض احترامها وحصولها هنا.
ـ المستقبلون يعرفون حقيقة المتكلّم، لذا لم ينكروا عليه مقام الوعظ في خطابه.
ـ المناسبة تقتضي أن يأتي بما يتناسب مع الأمر بالتقوى، وهو ما ذكره بعد أمره إيّاهم بتقوى الله (فإنّ ثقل محمد’ بين أظهركم)، وهو بهذا يعمل على تحقيرهم؛ لأنّهم مقدمون على قتل رسولهم ونبيّهم، والثقل هنا جيء به لتبشيع صورة الإقدام على القتل.
ـ أراد الباثّ أن يزيد في توضيح صورة العترة التي يريدون قتلها، بقوله: «هؤلاء ذرّيّته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم، وما الذي تريدون صنعه بهم»، وهو توبيخ مبطّن، إذ أنّ العرب كانت تأنف أن تجهز على البنات والحرم، وهذا ما قصده وأراد أن يوصله لأذهانهم العارية من النبل.
فقد كانت الملاءمة، والكيف حاضرتين في صورة هذا الخطاب، بعد شحنها بمعانٍ قصدية، أراد لها الباثّ أن تصل كي تحقّق تأثيراً، فلعلّ المستقبل يرعوى ويتراجع عن عزمه قتل الحسين×وآله. حيث استلزم هذا الاحترام للقواعد قصداً حجاجياً أدّى إلى انزياح الخطاب عن معانيه الحرفية المتمثّلة بالجمل الخبرية، إلى قصدية الإقناع بثنيهم عن الإقدام على القتل وانتهاك الحرمات، فقدّم من الأدلّة الحجاجية ما يكفي لردعهم، ولكنّهم أبوا إلّا عتوّاً ونفوراً، وران على قلوبهم.
رابعاً: حوار الإمام الحسين مع زينب ÷
قال: «لَوْ تُرِكَ الْقَطا[343] لَيْلاً لَنامَ، قالت: يا ويلتي، أفتغصب نفسك اغتصاباً[344]؟ فذلك أقرح لقلبي وأشدّ على نفسي، ثمّ خرّت مغشيّاً عليها، فقام إليها الحسين×، فصبّ على وجهها الماء، وقال لها: يا أخيّة، اتقي الله، وتعزّي بعزاء الله، واعلمي أنّ أهل الأرض يموتون، وأنّ أهل السماء لا يبقون، وأنّ كل شيء هالك إلّا وجه الله، الذي خلق الأرض بقدرته، ويبعث الخلق فيعودون، وهو فرد واحد. أبي خير منّي وأمّي خير منّي وأخي خير منّي، ولي ولهم ولكلّ مسلم برسول الله أسوة. فعزّاها بهذا ونحوه، وقال لها: يا أخيّة، إنّي أقسم عليك، فأبرّي قسمي، لا تشقّي عليّ جيباً، ولا تخمشي عليّ وجهاً، ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت»[345].
يلمس القارئ من هذا الخطاببراعة الأسلوب الخطابي ودقّته وتمكّن المُلقي من ناصية اللغة؛ إذ جاء كلامه موافقاً بين حالتين من حالات تقديم المعلومات، الحالة الأولى كانت متماشية مع مراعاة مجريات السياق المقامي، أي: احترام (الملاءمة)، والحالة الثانية منسجمة مع احترام قاعدة الطريقة، وذلك من خلال مجيئ سياق الملفوظات مرتّباً على وفق ما تقتضيه القاعدة الفرعية الرابعة من قاعدة الطريقة[346]، فتجد الإمام×عمد إلى لفت انتباه أخته زينب، ومناداتها بأحبّ وأقرب الألفاظ على قلبيهما، ثمّ بعد ذلك رتّب الكلام. ومع أنّ الظروف والسياق المفاجئ يشيران إلى أنّها‘قد أُغشي عليها إلا أنّ الإمام×تمكّن من لفت انتباهها إليه، فأخذ يوجّهها ويذكّرها بتقوى الله أولاً، ثمّ التعزّي، أي: التصبّر[347]والتقوّى بقوّة الله تعالى وغلبته[348]. ومن خلال تقديم المعلومات في سياق ملفوظات مرتبة جاء كلامه مرتباً، فبدأ بذكر فناء أهل الأرض قبل أهل السماء، ثمّ أكّد أنّ كل شيء هالك إلّا وجه الله، وعرّج إلى ذكر سبب بقاء وجه الله الذي خلق الأرض بقدرته، ثمّ ذكّرها بالبعث، وانتقل إلى ذكر صفات الله تعالى، وأخذ يسترسل بذكر أفضليّة أبيه وأمّه وأخيه^ وتأسي الجميع بأسوة العالمين جدّه المصطفى’. حيث يمكن أن يُستجلى من كلّ ما تقدّم مجموعة من المقاصد كانت وراء ترتيب المعلومات وتسلسلها مع ملاءمتها لمجريات السياق المقامي:
1ـ بيان حتميّة وقوع المصيبة والفاجعة.
2ـ تهيئة الأسرة ومن سيتولى بعده قيادة ركب المسيرة الإصلاحية لهول المصاب الذي سيلقونه، إذ لا بدّ من التعرّف على مجريات الأمور على وفق حجمها الطبيعي، فبدى حجم المصيبة عظيما، وجاءت ردود الفعل كبيرة، ما جعل الإمام ينتقل ـ تداولياً ـ إلى المقصد الثالث.
3ـ يشدّ عزمهم، ويقلّل من هول المصيبه وحجمها، وتقوية أخته العقيلة‘، والربط على قلبها، وتذكيرها بمصير حال من هم أفضل منه عبر ترتيب الملفوظات والاستدلال. فطبيعة المتكلّم والمقام وحالة المتلقّي كلّها مجتمعة تحدّد حجم المصيبة.
خامساً: خطاب السيّدة فاطمة بنت الإمام الحسين × لأهل الكوفة
حين استقر ركب السبايا في الكوفة توجّهت إلى أهلها مُخاطبة، فقالت: «تبَّاً لكُمْ، فانْظُروا اللَّعْنة والعَذاب»[349]، إذ جاء خطابها‘ موجّهاً لأهل الكوفة الذين قتلوا والدها وأهل بيتها^، وموافقا للمناسبة وظروف المقام، حيثاستثمرت الفعل اللّغوي المباشر الذي دلّت عليه القرينة (صيغة الأمر) في إنجاز معنيين:
1ـ المعنى القضوي الذي تؤكّده الدلالة الظاهرية للتركيب، المستفادة من أمرهم بانتظار العذاب على وجهة الإلزام، فالأمر «طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام، ويقصد بالاستعلاء أن ينظر الآمر لنفسه على أنّه أعلى منزلة ممّن يُخاطبه، أو يوجّه الأمر إليه، سواء أكان أعلى منزلة منه في الواقع أم لا»[350]. وهي‘مع أنها أعلى منزلة منهم في الواقع، إلّا أنّ مناسبة المقام اقتضت خروج الأمر على غير الظاهر.
2ـ القصد المستلزم: وهو أنّ خروج الفعل اللّغوي على غير مقتضاه أنجز فعلاً لغويّاً غير مباشر، استلزم منه قصدها توبيخ المتلقّي وتوجيه ذهنه من خلال التهديد والوعيد لما ينتظره من العذاب، وهذا ما يناسب احترام قاعدة المناسبة، فهي مع كونها في حالة لوعة وحزن شديدين؛ لقتل أبيها الإمام الحسين×، قد جاءت بما يؤكّد هذا المعنى الذي خرج إليه القصد، فقرنت (الفاء) بفعل الأمر لتؤكّد هذا القصد، في نهاية الخُطبة بقولها: «فَاكْظِمْ وَاقْعَ كَما أقْعَى أَبوك»[351]، وهي لم تقصد بالأمر الإيجاب والإلزام، بل استُلزم من استعمالها هذا قصد توبيخ المتلقّي وتقريعه، إذ شبّهته بالكلب حينما يجلس، لما فيه من تحقير وتقريع له. فالإقعاء من أقعى الكلب إذا جلس على أسته مفترشاً رجليه وناصباً ساقيه[352]، وهو أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره.
سادساً: خطاب السيدة زينب أمام أهل الكوفة
قالت السيدة زينب‘ في خُطبتها أمام أهل الكوفة: «هل فِيكم إلّا الصَّلِفُ والعَجِبُ والشَّنفُ...، أَتَبْكُون أَخي؟.. أتَدْرون ـوَيْلكُمـأَيَّ كَبِدٍ لِمحمَّدٍ’ فَرَيتم؟ وَأَيَّ عهْدٍ نَكَثْتُم؟ وَأَيَّ كرِيمَةٍ لَهُ أَبْرزتُمْ؟ وَأَيَّ حُرْمَةٍ لَهُ هَتَكْتُم؟ وَأَيَّ دمٍ لَهُ سَفَكْتُم؟.. أَفَعجِبْتُم أَن تُمْطِر السمَاءُ دَمَاً»[353].
مما يعين الخطيب على بلوغ مقاصده على وفق احترام المناسبة، هو حسن تمكّنه من إطلاق جماليات التعبير وتأثيراتها في صياغة الحوار، ومنها: الاستفهام[354]، فكثير من الحوارات تبنى على طريقة السؤال والجواب «وهي طريقة حوارية بارعة تدفع بالخصم دفعاً إلى النتيجة التي يريدها المحاور»[355]؛ لأنّ العقيلة‘ اختارت من الأسئلة التي تعلم أنّ إجابتها تدفع نحو النتيجة التي تريد، ولو تأمّل القارئ أسلوب الاستفهام الذي وظّفته السيّدة‘، لعلم أنّه «من أوفر أساليب الكلام معاني، وأوسعها تصرّفاً، وأكثرها في مواقف الانفعال وروداً...، وحيث يُراد التأثير وهيجان الشعور للاستحالة والإقناع، فالاستفهام أقدر تلك الأساليب على الوفاء بحقِّ تلك المواقف»[356]، إلّا أنّها لم تكن تنتظر الجواب، فهي تدرك أن حقيقة الاستفهام تأتي لـ«طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل، بأداة خاصّة»[357]. وهذا ما استلزم مقاصد عديدة، منها أنّها:
أنكرت‘عليهم فعلتهم التي خذلوا بها الإمام الحسين×، مُستثمرة الموقف بقصد تأجيج المشاعر، وإثارة الحماس في نفوسهم، بعد أن نبّهتهم على جسامة ما اقترفوه بحقّ إمام مفترض الطاعة. حيث وجّهت الخطاب لهم مُرجعة ضمير المُخاطب عليهم وحدَهم، من غير أن تترُك احتمال وجود مُشاركٍ لهم في الجريمة، مع يقينهاـ ويقينهم ـ أنّ الجريمة تَمَّتْ بأمر من يزيد، وهذا ما سوّغ إعطاء الخطاب استلزاماً تداولياً، القصد منه كشف حقيقة خطئهم على مقدار ما اقترفوه.
سابعاً: خطاب السيدة أم كلثوم‘ في أهل الكوفة
تستلم السيدة أم كلثوم‘خطاب التقريع لأهل الكوفة قائلة: «ويلكم، أتدرون أيّ دواهٍ دهتكم؟ وأيّ وزرٍ على ظهوركم حملتم؟ وأيّ دماءٍ سفكتموها؟ وأيّ كريمةٍ أصبتموها؟ وأيّ صبيّةٍ سلبتموها؟ وأيّ أموالٍ انتهبتموها؟»[358]، وقد ترك تقديم الحوار بأسلوب الاستفهام المتكرّر منها، أثراً بليغاً في نفوس المستمعين من خلال الكشف عن عظم المُصاب الذي لحق آل البيت^إثر ما اقترفه القوم. وقد بدت أهمّيته بارزة لما استلزمه من معانٍ أُخر غير الاستفهام الحقيقي:
1ـ جاء الاستفهام إنكارياً، كاشفاً عداء هؤلاء القوم للبيت العلوي.
2ـ استلزم التعجّب ممّن قتل ابن بنت نبيّهم’، وهذا ما سوّغ للسيدة أم كلثوم‘ أن تأتي بالاستفهامات مُتتالية بلا فاصل، لإظهار فداحة جريمتهم.
ثامناً: حواريّة الإمام الحسين × مع الطرمّاح بن عدي الطائي
بعد أن عرض الطرمّاح على الإمام الحسين× نصرته هو وعشيرته؛ أطلعه على أخبار الكوفة، فقال×: « جزاك الله وقومك خيراً، إنّه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول، لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علام تنصرف بنا وبهم الأمور في عاقبة»[359].
حتى نلمس تفاعل خطاب الإمام وتباينه مع الطرمّاح وأصحابه مع مجريات السياق المقامي، يحرص المنهج التحليلي على تناول المحادثة بتفاصيلها؛ كي تتّضح مقاصد الحوار بشكل واضح وجلي، وقد جاء ذلك على ثلاثة مستويات:
المستوى الأوّل: هو مستوى الاستفهام والسؤال عن أخبار الكوفة ورأي النّاس، فأخبروه بذلك، وبقصّة مقتل مبعوثه قيس بن مسهّر الصيداوي، فقال×: (منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلاً)، وهنا قصد الإمام× التلويح للإصرار على الشهادة وبتوطين الأنفس على ذلك، كل حسب دوره ومسؤوليّته، ودعا لهم بقوله: «اللهم اجعل لنا ولهم الجنّة نزلاً، واجمع بيننا وبينهم في مستقرّ رحمتك ورغائب مذخور ثوابك»[360]، فمع كون هذا الخطاب دعاءً لكنّه جاء محمّلاً بدلالتين:
المعنى القضوي: وهو الدلالة الحرفية المعجمية لعناصر التركيب، وهو النداء والأمر.
المعنى المستلزم: وهو التلويح للمتلقّي (الطرمّاح وأصدقائه) بأنّ كل من صحب الحسين×، وكل من قضى نحبه في ركب الحسين، سيحظى بدعاء الحسين، وسينال الجنّة وصحبة أهل البيت^، وهذه الصحبة هي في مستقرّ من رحمة الله ورضوان، بما «لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»[361].
المستوى الثاني: وهو مستوى خرج إلى التضامن من لدن الإمام×حينما خاطب أصحابه بقوله: «لأمنعنّهم مما أمنع منه نفسي، إنّما هؤلاء أنصاري وأعواني»[362] عندما حاول الحرّ حبسهم، فالإمام×يفتتح خطابه معهم (أنصاري وأعواني) ذات الدلالة الاجتماعية على التلاطف القربي؛ ليخلق جوّاً من التبادل العاطفي مع الطرمّاح ومن معه، ولا شكّ أنّ قوله هذا يخلق تبادلاً قيميّاً، فلا يتصوّر السامع معها أنّ الخطاب سينطوي بعد ذلك على غير المكاشفة الدالة على التضامن مع المتلقّي، الذي يرشّح هذا المعنى قوله بعد ذلك «هم أصحابي، وهم بمنزلة من جاء معي، فإن تمّمت على ما كان بيني وبينك وإلّا ناجزتك»[363]وهو خطاب تضامني عالي المستوى منه×، يستلزم مقاصد عدّة:
1ـ تقوية موقفهم تجاه حكومة عبيد الله بن زياد، الذي أصدر أوامره للحرّ الرياحي بحبسهم؛ لأنّهم مؤمنون ورافضون للظلم وقلوبهم مع الحسين×، فحينما ينسبهم الحسين لنفسه، سيكون حتماً موقفهم أقوى.
2ـ النهي والترك عمّا عزم عليه الحرّ من حبسهم: «وأقبل إليهم الحرّ بن يزيد فقال: إنّ هؤلاء النفر الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل معك، وأنا حابسهم، أو رادّهم»، فقد هدّده الإمام× بالقتال إن نقض ما كان بينهما، ممّا جعله يكفّ عنهم.
3ـ قصد الإمام×محاججة الحرّ، ومن ثمَّ إقناعه، وتأتي أهمّية الإقناع بوصفه هدفاً واستراتيجية تحقّق القصد الخطابي في كثير من الخطابات، يستعمل المرسل فيه آليات كثيرة وأدوات لغوية وغير لغوية[364]، حيث وظّف الإمام×أسلوب التركيب الشرطي. إذ الشرط هو توقّف الشيء على غيره، أو هو توقّع حصول الشيء لوقوع غيره[365]، كما أنّ جملة الشرط من أكثر أنواع الجمل ملاءمة للغرض الجدلي الحجاجي، المفيدة مع شرطها أنّ المقدّمة إن كانت صالحة، فإن النتيجة ستكون حتماً كذلك، والعكس بالعكس[366]. لذلك يمكن استثمار التركيب الشرطي في أغراض الجدل القائم على توالي المقدّمات ونتائجها. وقد استلزم حوار الإمام الحسين×عبر أسلوب الشرط معنيين، هما:
المعنى القضوي: وهو ما دلّت عليه الدلالة الحرفية لعناصر التركيب، وهي الإخبار بحقيقة هؤلاء القوم.
القصد المستلزم: تذكير الإمام× للحرّ، ونهيه عن التعرّض لأصحابه مادام لم يأته كتاب عبيد الله بن زياد، بقوله «وقد كنت أعطيتني ألّا تتعرّض لي بشيء حتى يأتيك كتاب من ابن زياد، فقال: أجل، لكن لم يأتوا معك، قال: هم أصحابي، وهم بمنزلة من جاء معي، فإن تمّمت على ما كان بيني وبينك وإلّا ناجزتك...» وهنا الإمام× خيّره من خلال استلزامه الفعل اللّغوي المباشر، الذي دلّت عليه القرينة بقوله (أعطيتني)ما بين أن يلتزم بالعهد وبما قطعه على نفسه، وبين القتال.
المستوى الثالث: وهو ما ختمت به الحوارية، حيث لم يُفارق الهدوء والطمأنينة، والسكينة، والاستقرار الإمام×، مما يستلزم منه الافصاح عن عمق الإيمان في أداء الواجب، فضلا عن استلزامه التضامن ـ أيضاً ـ الذي ترشّح عن دعاء الإمام× بقوله: «جزاك الله وقومك خيراً»، وقد جاء جواب الإمام× بعد ما قدّمه الطرمّاح من عرض، في سياق التزام الإمام×مع أهل الكوفة؛ بقوله: «إنّه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول، لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علام تنصرف بنا وبهم الأمور في عاقبة»[367]، حيث يستلزم قوله هذا، أموراً عدّة:
1ـ الاستجابة لاستغاثة أهل الكوفة، وقد عبّر عنه في موقف آخر «فحين استصرختمونا وجلين فأصرخناكم موجفين»[368].
2ـ إنَّ أهل الكوفة كتبوا إليه أنّهم يبايعونه، ويولّونه عليهم بقولهم: «فأقدم علينا، فإنّك إنّما تقدم على جند مجنّدة»[369]، وهنا يمكن أن ترد عدّة إشكالات تتعلّق بالهدف، والقصد الذي استلزمه خطاب الإمام×، لعدم قبول العروض التي قدّمت له، سواءٌ من عبد الله بن عباس، أم من الطرمّاح الذي كان قريباً من أخبار أهل الكوفة وأوضاعهم التي انطوت على نكث البيعة وعلى الغدر. ويستلزم من كل هذه الإشكالات سقوط تكليف الإمام×وانتفاؤه[370]، حيث انطوى العرض الذي قدّمه الطرمّاح على مقترح ذكي، يكشف عن الفرق بين منطق النّاس العاديين ومنطق الشهداء، فلكلٍّ معايير ومقاييس يُحدّد بموجبها موقفه من المسائل والأحداث. كما لا يمكن قياس أو مقارنة منطق الشهيد بمنطق النّاس العاديين؛ لأنّه أسمى وأرقى لمزجه بين منطق المصلح ومنطق العاشق، فالمصلح يتضوّر قلبه ألماً لمجتمعه، والعاشق يتضوّر شوقاً للقاء ربّه ومعشوقه[371]. نعم هو تفكير منطقي، لكنّه ليس تفكير المصلح العاشق ومنطقه الذي يتحرّق شوقاً للقاء ربّه، ويروم الانصهار في جسم المجتمع المظلوم؛ ليعيد له حقّه المغتصب في جسد الأمة الميّت، وليبعث فيه حياة القيم الإنسانية من جديد.
3ـ إعطاء المثل الأعلى للدين الحنيف، الذي يستحقّ هذا القدر العظيم من التضحية والفداء؛ حتى تطبّق الأحكام الإسلامية والشعائر الدينية[372].
تاسعاً: حواريّة مبعوث قيصر الروم مع يزيد[373]
قال: «يا ملك العرب، رأس من هذا؟ فقال له يزيد: ما لك ولهذا الرّأس؟ قال: إنّي إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كلّ شيء رأيته؛ فأحببت أن أخبره بقصّة هذا الرّأس وصاحبه؛ ليشاركك في الفرح والسّرور، فقال يزيد: هذا رأس الحسين بن عليّ بن أبي طالب، فقال: ومن أمّه؟ قال: فاطمة الزّهراء، قال: بنت من؟ قال: بنت رسول الله، فقال الرّسول: أفٍّ لك ولدينك، ما دين أحس[374] من دينك، اعلم أنّي من أحفاد داود، وبيني وبينه آباء كثيرة، والنّصارى يعظّمونني ويأخذون التّراب من تحت قدميّ تبرّكاً؛ لأنّي من أحفاد داود، وأنتم تقتلون ابن بنت رسول الله وما بينه وبين رسول الله إلّا أمّ واحدة، فأيّ دين هذا؟ ثم قال له الرّسول: يا يزيد، هل سمعت بحديث كنيسة الحافر؟ فقال يزيد: قل حتّى أسمع[375]...، فقال يزيد لأصحابه: اقتلوا هذا النّصرانيّ؛ فإنّه يفضحنا إن رجع إلى بلاده ويشنّع علينا، فلمّا أحسّ النّصرانيّ بالقتل، قال: يا يزيد، أتريد قتلي؟ قال: نعم، قال: فاعلم أنّي رأيت البارحة نبيّكم في منامي وهو يقول لي: يا نصرانيّ، أنت من أهل الجنّة، فعجبت من كلامه حتّى نالني هذا، فأنا أشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، ثمّ أخذ الرّأس وضمّه إليه، وجعل يبكي حتّى قتل»[376].
يمكن أن يُستشفّ جملة من المقاصد التي انطوت عليها المحادثة في ضوء قاعدة الملاءمة ووضوح الألفاظ حوارياً، جاءت متناغمة مع مجريات السياق المقامي على منوالين:
المنوال الأوّل: ما تمتّع به مبعوث القيصر من ذكاء، وفطنة، وبراعة في استدراج يزيد من خلال مقصديّة التضامن والإقناع التي سلكهما بما يناسب مجريات المقام[377].
حيث بدت أهم مسوّغات استراتيجية التضامن التي استلزمتها قاعدة الملاءمة في كسب ولاء النّاس، وتأسيس الصداقة بين طرفي الخطاب، والتركيز على حسن التعامل مع صاحب السلطة... إلخ[378]. أمّا أبرز مسوّغات استراتيجية الإقناع التي اقتضتها قاعدة الملاءمة فهي شموليّتها؛ إذ تستعمل في جميع الأصعدة، وتأثيرها التداولي في المتلقّي أقوى؛ لأنّها تحقّق النتائج دون فرض أو قوّة، ونتائجها تبتعد عن سوء فهم أو تأويل الخطاب[379].
ولتحقيق مقصديّة التضامن ووسائله، لا بدّ من توفر أداة التضامن، وهي التعبير الإطرائي؛ إذ يعمد منشئ الخطاب لاختيار ألفاظٍ تدلّ على التضامن والتقرّب من المتلقّي، فيجعلها دليلاً ومؤشّراً لغوياً في خطابه من خلال إنجاز بعض الأفعال اللّغوية، مثل: السلام والحمد والثناء والتهنئة والترحيب وغيرها[380]، وقد سمّته "هدى عبد الغني باز" بالتفضيل التعبيري[381]، وبتطبيقه على ما نحن فيه نجد أنّ مبعوث القيصر أطلق تعبير (يا ملك العرب) الذي استلزم من ظاهره تضامنه مع يزيد، مع أنّ ما آلت إليه الحوارية استلزم غير ذلك.
المنوال الثاني: الذي ناور فيه مبعوث القيصر مع يزيد بقصد التضامن أولاً من خلال الفعل الكلامي غير المباشر؛ الذي يخوّل للمتكلّم إفهام المتلقّي إيصال رسالته بصورة مباشرة في ضوء الخطاب المباشر، أو بواسطة الخطاب غير المباشر، وهو الاستراتيجية البديلة للخطاب المباشر؛ لئلّا يكون الإخفاق مآل الخطاب. ولإنجاز ذلك لا بدّ من توفّر شروط مشتركة بين فهم الخطاب المباشر وغيره، من أهمّها:
1ـ معرفة أصول اللغة بمستوياتها كافّة.
2ـ معرفة دلالات هذه الأصول.
3ـ معرفة كيفيّة إنتاج الخطاب على وفق ما تقتضية الأحوال والسياق المقامي[382].
والمعرفة بهذه الشروط هي نتاج الكفاية اللّغوية التي يمتلكها الإنسان السويّ، وكل شخوص الخطاب ـ آنذاك ـ من مرسلٍ ومتلقٍّ كان على قدر ليس بالقليل من الكفاءة اللّغوية، ويرى الصرّاف أنّ من أهمّ المسوّغات التي تدفع المرسل إلى استعمال الخطاب غير المباشر[383]:
1ـ التأدّب في الخطاب مع الذات أو مع المتلقّي، أو مع مكان الخطاب.
2ـ تجنّب إكراه المتلقّي أو إحراجه لإنجاز فعل قد يكون غير راغب في إنجازه.
3ـ الاستغناء عن إنتاج عدد من الخطابات، والاكتفاء بإنتاج خطاب واحد؛ ليؤدّي معنيين في الآن نفسه، هما: المعنى الحرفي والمعنى غير المباشر.
4ـ رغبة المتكلّم في التخلّص والتهرّب من مسؤولية الخطاب؛ يجعل الخطاب يحتمل أكثر من تأويل، منها القريب ومنها البعيد، فيلجأ المتلقّي إلى التأويلات الممكنة والمناسبة للسياق.
5ـ استجابة المتكلّم لمخاوفه تدفعه لاستعمال تلك الأفعال، لئلّا يتّخذ المتلقّي خطابه دليلاً عليه.
وقد تحدّثت عن تلك الأفعال غير المباشرة روبين لاكوف في سياق حديثها عن مبدأ التأدّب الذي تفرّعت عنه ثلاث قواعد، أطلقت عليها قواعد تهذيب الخطاب[384].
إنّ المبعوث (السفير) يمثّل رئيس دولته أمام الدولة المعتمد لديها، كما أنّه يمثّل وزارة الخارجية والوزارات الأُخر[385]، واعتمد على قدرة وإمكانية يزيد في إعمال عقله في القياس والانتقال من العام إلى الخاص بقوله «يسألني عن كل شيء رأيته» والرأس بعض هذه الأشياء، ثم انتقل إلى التعليل، وهو أحد وسائل الإقناع اللّغوية التي يطلقها المتكلّم ليشكّل خطابه الإقناعي وبناء حججه فيه؛ بحيث يستعملها الخطيب ليبرر فعله أو تعليله بناءً على سؤال متلفّظ أو مستلزم، ومن ألفاظ التعليل المفعول لأجله، لام التعليل[386]...الخ. وتقدير هذا السؤال الذي جاء ملائماً، ومناسباً حوارياً هو: لِمَ يسألك؟ فيأتي الجواب؛ ليشاركك في الفرح والسّرور، وهذا ما دفع يزيد إلى البوح والتعريف باسم صاحب الرأس، دونما خوف أو وجل، بعد أن تحقّق قصد المبعوث، وهو إقناع يزيد الذي تردّد، وأنكر سؤال المبعوث بقوله: «مالك والرأس»؟! إلاّ أنّ المبعوث تأكّد من حقيقة صاحب الرأس عبر تكرار السؤال الذي جاء مناسباً حوارياً على وفق مجريات الأحداث مقامياً. ويمكن أن نستنتج من هذه الحوارية مقاصد عدّة جاءت حاكية عن معنيين:
المعنى القضوي: وهو ما أفادته الدلالة الحرفية المعجمية لعناصر التركيب؛ أي: الاستفهام والتعليل.
القصد المستلزم: التعريض والتشكيك بدين يزيد وبإسلامه الذي جاء على خلاف المبادئ السمحة التي جاء بها دين جدّ صاحب الرأس الشريف^، وهو ما يستنتج من الاستلزامات الآتية:
أ ـ كشف حقيقة هذا الملك ـ الذي نصب نفسه مدّعياً خدمة البلاد والعباد ـ للقيصر وللحاضرين.
ب ـ إظهار أفضليّة الديانة (النصرانية) بقوله: (أفضل من دينك يا يزيد) الذي جاء كأحد وسائل الإقناع، متعمّداً إيصال مفاد ذلك إلى المتلقّي ـ يزيد ـ، وأردفه استدلال عبر خرق قاعدة الملاءمة تمثّل بسؤال يزيد عن كنيسة الحافر؛ إذ لو كان يزيد قد سمع بها ووعاها لما أخبره المبعوث بحقيقة صاحب الرأس على أقلّ تقدير؛ خوفاً من النتائج المترتّبة على ذلك، وإنّما المبعوث زاد في ذكرها خارقاً القاعدة؛ بقصد الزيادة في التعريض والنكاية بيزيد وفعلته الشنيعة المتعلّقة بصاحب الرأس الشريف وأهل بيت النبي^.
يمكن أن يستشفّ من هذه الحوارية أنّ قضيّة الإمام الحسين× لم تعد خاصّة بطائفة أو اتجاه مذهبي معيّن، بل إنّها أصبحت تيّاراً يجذب جميع الطبقات الفكرية والاجتماعية في العالم، وإلى مثل هذا الرأي ذهب عبد الرحمن بدوي؛ بقوله: إنّ ثورة الحسين لو لم تتحقّق لأصبح الإسلام عند أهل السنّة مثل المعادلات الكيميائية، مُفرغاً من الجانب الروحي. بعبارة أخرى: إنّ ما بقي في الدين الإسلامي من جوانب روحية وعاطفية وأخلاقية لدى أهل السنّة هي مدينة للإمام الحسين×، فالثورة الحسينية وإن كان أثرها في شيعته بشكل مباشر، لكنّها أثّرت في المسلمين بشكل غير مباشر؛ لأنّ القوانين الأموية والقوانين العبّاسية وسياستهم كانت ستحوّل الدين الإسلامي إلى دين وضعي مثل الماركسية. فبفضل الإمام الحسين×حافظ المسلمون على الصبغة الإلهية ولو بشكل فاتر لدى المذاهب السنّية، وسبب ذلك الفتور يرجع إلى التصوّر المغلوط عند الكثير من أهل السنّة بأنّ ثورة الحسين خدمت الشيعة فحسب[387].
لما كان السياق المقامي الحجر الأساس في تأويل الملفوظات تأويلاً تداولياً وتفسيراً للتواصل الإظهاري ـ بشكل عام ـ الضمني والصريح على السواء[388]؛ خصّص غرايس مبدأً في استلزامه الحواري، أطلق عليه مبدأ الصّلة أو قاعدة المناسبة أو العلاقة (الملاءمة)، وهي «بمثابة حدٍ مقصدي الهدف، منها منع المتكلّم من أن ينزلق إلى مقاصد أخرى مخالفة لتلك التي استهدفها الخطاب، أي: يراعي علاقة المقال بالمقام»[389].
ويرى دان سبيبر أنّ مبدأ الصّلة ينطبق ويتحقّق ـبغير استثناءـعلى كل فعل من أفعال التواصل الإظهاري؛ لأنَّه (فعل التواصل) يعبّر عن افتراض صلة، أو مناسبة بين طرفي الحوار[390]. إلّا أنّ لخرق قاعدة المناسبة مقصديّة أسمى في التحليل التداولي؛ فهي أداة يتوصّل بها المتلقّي إلى تأويل أقوال وتحليلها. إذ ليست لها علاقة جليّة مع ما يقال أثناء العملية التحاوريّة، ولكن بمعونة المقام والمعرفة السابقة بالظروف المحيطة يتجلّى ـشيئاً فشيئاًـتأويل المعنى الحرفي للخطاب[391]، ومنه يُتوصّل إلى مقصد المتكلّم. فتأويل الخطاب لا يتحصّل بشكل اعتباطي، بل يؤسّس على مجموعة من القرائن، يستحضرها المتلقّي من توظيف المتكلّم لتلك القرائن في خطابه. إذاً عملية التأويل الناتجة عن خرق هذه القاعدة، تحتاج إلى تضافر تعاوني من طرفي الحوار في التأويل؛ لأنّ المتكلّم قاصد هذا الخرق، والمتلقّي مضطرّ إلى بذل ما في وسعه لتحقيق نجاحٍ تواصلي، فضلاً عن احترام مبدأ التعاون. حيث يمكننا رصد نوعين من الخرق لهذا المبدأ في خطاب المسيرة الحسينية، هما:
الأوّل: خرق مقتضيات السياق المقامي
يتجلّى هذا الخرق المقامي في حادثتين:
الحادثة الأولى: ما دار بين برير بن خضير الهمداني[392]، وعبد الرحمن بن عبد ربّه الأنصاري[393]«فلمّا كان الغداة أمر الحسين× بفسطاط فضرب، وأمر بجفنة فيها مسك كثير، فجعل فيها نورة[394]، ثمّ دخل ليطلي[395]، فروى أنّ برير بن خضير الهمداني وعبد الرحمن بن عبد ربّه الأنصاري وقفا على باب الفسطاط ليطليا بعده، فجعل برير يضاحك عبد الرحمن، فقال له عبدالرحمن: يا برير، أتضحك؟ ما هذه ساعة ضحك ولا باطل، فقال برير: لقد علم قومي أنّني ما أحببت الباطل كهلاً ولا شابّاً، وإنّما أفعل ذلك استبشاراً بما نصير إليه، فو الله ما هو إلّا أن نلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم بها ساعة، ثمّ نعانق الحور العين»[396].
ففي هذا الحوار القصير الذي أفضى عن مقاصد جمّة، تتجلّى فيه براعة أصحاب الإمام×وقمّة إخلاصهم وشجاعتهم، فبرير ـهناـفي سياق هذا الموقفالذي يقتضي التوتّر والشدّة والتهيّؤ للعدو ـوهذا أمر طبيعي لعامّة النّاس ـ قد تعمّد خرق سياق المقام مع عبد الرحمن وملاطفته له والضحك عند اشتباك الأسنّة واشتداد الضرب، أمر قد ألِفه من أئمّته وهم علي بن أبي طالب وذرّيّته^، ويستلزم من هذا التصرّف السيميائي اطمئناناً ويقيناً عاليين وتوطيناً للنفس.
فضحك برير هو إشارة للفرح والسرور، أو بشارة بأخبار سارّة تستوجب التعبير عن الرضا، ولو تأمّلت المقام الذي كانا فيه، وهو غداة اليوم الذي سبق مقتل الحسين× وأهل بيته وأصحابه، لوجدت هذا الكمّ الهائل من العدّة والعدد في معسكر ابن سعد لا يستوجب الضحك بدلالته المتعارف عليها. إذ يستبعد أنّ شخصيّة كشخصيّة برير، يصدر عنها هذا السلوك اعتباطاً.
وعليه يكون برير قد قدّم بسلوكه معنيين، هما:
المعنى الحرفي: سلوك يدلّ على الفرح باستعماله التداولي (الضحك).
القصد المستلزم: تلميح واستلزام مقامي حواري من برير إلى صاحبه عبد الرحمن
وكل
من يراه؛ إذ «حكم
المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأنّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية، وممتدّة إلى غير نهاية،
وأسماء المعاني مقصورة معدودة ومحصّلة محدودة، وجميع أصناف الدلالات على المعاني من
لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد، أوّلها اللفظ، ثمّ الإشارة، ثمّ العقد،
ثمّ الخطّ، ثمّ الحال وتسمّى نصبة، والنصبة هي الحال الدالّة التي تقوم مقام تلك الأصناف،
ولا تقصر عن تلك الدلالات، ولكل واحد من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها،
وحلية مخالفة لحلية أختها، وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في الجملة، ثمّ عن حقائقها
في التفسير»[397]. أحياناً
تكون الحركات ـكالإشارة
وغيرها ـ أجدى لتحصيل المقصود من الكلام؛ حيث «يقوم المتكلّم باختيار مختلف أنواع الحوامل
الشكلّية وغيرها، الكفيلة بتحقيق التواصل، التي من بينها: اللّسان، والحركات
والإيماءات، والنبر والتنغيم»[398]،
فالتداولية تؤكّد الظروف القبلية الخارجية والداخلية المشتركة بين المتحاورين،
التي أطلق عليها (علم استعمال اللغة)؛ مؤكّدين أهمّية العوامل غير اللّغوية ـ التي
تكتنف الخطاب ـ في تأويل القول وإدراك المقاصد، وحتميّة معرفة الشروط القبلية التي
تدخل في صناعة القصد الناتج عن القول، وهذا ما يعطيها الأهمّية التي تتمتّع بها
على المستوى التنظيري والتطبيقي[399]، فالقصد
المتضمّن كان لرفع الحالة المعنويّة عند عبد
الرحمن ومن يشاهده من خلال الاستخفاف، واستصغار الموقف بعين الطرف الآخر، بدليل قوله: (ما هي إلّا ساعة، نميل على القوم فيميلون علينا، فنعانق الحور العين)، لاسيما أنّ سيرة برير تستبعد الحالة الأخرى للضحك، من وصف صاحبه بالسّفه، وقلّة العقل، وعدم إدراك الأمور، كما فهم المحاور منها، فاعترض بقوله: (أهذه ساعة ضحك) فالمعنى القضوي لقول عبد الرحمن هي الدلالة الحرفية للاستفهام، في حين المعنى المستلزم هو الإنكار والرفض لهذا السلوك.
الحادثة الثانية: تكلّم رأس الإمام الحسين× ـبعد أن رُفع على الرمحـفقد نقل التاريخ عن المفيد أنّه قال: «ولما أصبح عبيد الله بن زياد بعث برأس الحسين×، فدير به في سكك الكوفة، وقبائلها، فروي عن زيد بن أرقم[400] أنّه قال: إنّه مُرّ به عليّ وهو على رمح، وأنا في غرفة لي، فلمّا حاذاني سمعته يقرأ (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا)[401] فوقف ـواللهـشعري علي، وناديت: رأسك ـيا ابن رسول اللهـأعجب وأعجب»[402]، وروي ـ أيضاًـ «هذا الخبر عمّن سمع رأس الحسين× يتلو آيات من سورة الكهف، ولم يصلنا ذلك عن أحد من الأئمة^، لكنّي لا أنكره، بل أراه حقاً، فإذا جاز في يوم القيامة لأيدي المجرمين وأرجلهم أن تتكلّم، وهو ما ورد في القرآن (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)[403]، فيصحّ أن ينطق رأس الحسين، ويلهج لسانه بالقرآن، وهو خليفة الله، وإمام المسلمين، وسيّد شباب أهل الجنّة، وجدّه محمّد المصطفى، وأبوه علي المرتضى، وأمّه فاطمة الزهراء، بل إنكاره إنكار لقدرة الله وفضل صاحب الرسالة، والعجب لمن ينكر صدور مثل هذا عمّن بكته الملائكة»[404]، وهنا يحقّ للباحث في ضوء آليات المنهج التداولي أن يتساءل: هل يحقّ لنا تصديق هذه الرواية؟
وفي الجواب نقول: بدواً يُعتقد أنّه من المستحيل تكلّم الموتى مطلقاً، فضلاً عن كون الرأس مقطوعاً، ومضى على قطعه وقت طويل دون أن يحفظ طبّياً[[405]]!، إلاّ أنّ المنهج التداولي يحرص على أهمّية العوامل القبلية غير اللّغوية التي تحيط بالخطاب في تأويل القول وإدراك القصد. فالمدوّنة أمام خطاب لرأس الإمام الحسين×، وهي إشارة واضحة لكون مسيرته الاصلاحية لم تنتهِ بقتله واستشهاده× ـ كما تَوَهّم أعداؤه ـ، بل بدأت منذ خروجه من مكّة، واستمرّت إلى يومنا هذا، بشهادة خطاب هذا الرأس الذي لوّحَ إلى معانٍ عدّة:
1ـ المعنى القضوي: هو الدلالة الحرفية لعناصر التركيب المعجميّة، التي أرادت الإخبار بالإعجاز في قصّة أصحاب الكهف الذين أماتهم الله ثلاثمائة وتسع سنين.
2ـ المعنى المستلزم: وهو ما قصده الإمام×عبر خرق قاعدة المناسبة الذي حصل من جهاتٍ عدّة:
أ ـ أنّ المقام ليس مقام خطاب، فقد قُضي الأمر باستشهاده×كما حسب ابن زياد، مما جعله يطمئنّ، فأمر أن يطاف به في أزقّة الكوفة وأسواقها.
ب ـ أنّ النّاس في الأزقّة والأسواق مشغولون عن التوجّه إلى خطاب الإمام×الذي خذلوه حيّاً ومستشهداً، ومع كل هذه الظروف القبلية التي أحاطت بالخطاب إلّا أنّ صاحبه أصرَّ على توجيه خطابه للجميع، ولفت انتباههم إليه[406] مع عدم وجود السياق الحالي والمقامي (المناسبة)[407]، ومما يعضد هذا الرأي هو ردّ زيد بن أرقم على الرأس الشريف بقوله: (بل رأسك سيّدي أعجب وأعجب)[408].
وفي رواية أخرى عن المنهال بن عمرو، قال: «رأيت
رأس الحسين×بدمشق على رمح، وأمامه رجل يقرأ سورة الكهف
حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى:
(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ... ). نطق: أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملى»[409]. وأهمّ
المقاصد المنتزعة من هذه الرواية؛ هي:
1ـ مناسبة الإعجاز المستفاد من الآية التاسعة في سورة الكهف، والتي تعلّقت بأصحاب الكهف، الذين كانوا موحّدين ومضطهدين من قبل السلطان الجائر، ويعيشون في مجتمع رضي بالظلم دون وعي. وقد حفظ الله أجساد هذه الثلّة المؤمنة بعد أجيال وحضارات متعددة؛ لتفرّدهم في طريق الحقّ والهداية؛ وليبيّن لنا أنّه قادر على نصر المستضعفين، وإرجاعهم إلى الدنيا ليدركوا حقيقة غلبتهم على القوم الظالمين، بدليل قوله تعالى (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ)[410].
2ـ قصد الإمام×هذه الآية بالذات؛ لأنّ فيها تلويحا وإشارة إلى رجعة الأوّلياء والصالحين، كما هو حال أصحاب الكهف، بل قضية أهل البيت^ أعجب وأعجب.
3ـ الإمام الحسين×في أوّل خروجه كان قاصداً الكوفة، التي استصرخته واستنهضته للخروج، إلّا أنّ السلطة الأموية منعته من دخولها، فأبى×إلّا دخولها وإيصال خطابه لها[411].
4ـ إنّ نطق الرأس الشريف كان لإقامة الحجّة على أهل الشام الذين كانوا يجهلون شأن صاحبه×وإمامته وصدق قضيّته، بل كانت السلطة الظالمة تغرس في أذهانهم أنّ هذا الموكب لسبايا غير مسلمين من الروم أو الزنج أو الديلم ونحو ذلك، فتعيّن على موكب الحسين×أن يثبت صدق قضيّته، وبالرغم من أنّهم لم يقصّروا في ذلك، لاسيما بعد أن تكلّم الإمام زين العابدين×، وزينب بنت علي×، إلّا أنّ الحسين×قصد المشاركة في هذه الحملة الإعلامية الموسّعة من خلال قراءته القرآن ورأسه فوق رمحٍ طويل، فجاءت مشاركته أوكد من كل تلك المشاركات؛ لسببين:
1ـ أنّه الشخص الرئيس والأهم في المسيرة الإصلاحية.
2ـ أنّ مشاركته إعجازية، وهاتان الصفتان لم تتوافرا لأيّ من المشاركين في معسكر الحسين×، مع علوّ مكانتهم وعظمة شأنهم[412].
الثاني: خرق مبدأ الملاءمة حوارياً
«وهو ما يحصل من الفعل التحاوري بين طرفي الخطاب، الذي يكون على غير ما يتوقّعه المتلقّي في الردّ، بعد أن كان متكلّماً، فهنا الأدوار تتبادل في التواصل التحاوري، ومما يوضّح الاستلزام الحاصل عن هذه الفقرة، ما جاء في هذه المحاورة التي دارت بين علي بن الحسين والإمام الحسين‘ حين استأذنه للبراز، وكان أوّل من قتل بالطف من بني هاشم بعد أنصار الحسين علي بن الحسين‘، فإنّه لما نظر إلى وحدة أبيه تقدّم إليه، وهو على فرس له، يُدعى ذا الجناح، فاستأذنه للبراز ـ وكان من أصبح النّاس وجهاً، وأحسنهم خلقاً ـ فأرخى عينيه بالدموع وأطرق، ثمّ قال: اللهم اشهد أنّه قد برز إليهم غلام أشبه النّاس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك، وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إليه، ثمّ صاح: يا بن سعد، قطع الله رحمك، كما قطعت رحمي، ولم تحفظني في رسول الله’، فلما فهم علي الإذن من أبيه شدّ على القوم، وهو يقول:
|
أنا علي بن الحسين بن علي |
فقاتل قتالاً شديداً، ثمّ عاد إلى أبيه، وهو يقول: يا أبت، العطش قد قتلني، وثقل الحديد قد أجهدني، فبكى الحسين× وقال: وا غوثاه، أنّى لي الماء، قاتل يا بني قليلاً واصبر، فما أسرع الملتقى بجدّك محمد’، فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً، فكرّ عليهم يفعل فعل أبيه وجدّه، فرماه مُرّة بن منقذ العبدي بسهم»[413].
في هذه الحوارية يجري الخرق في مضمار الحوار الذي دار بين علي بن الحسين والإمام الحسين÷:
ـ علي بن الحسين×: يستأذن أباه للمبارزة.
ـ الحسين×أرخى عينيه بالدموع وأطرق، ثم قال: «اللهم اشهد أنّه قد برز إليهم غلام أشبه النّاس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولك...».
ـ ثم صاح: «يا ابن سعد، قطع الله رحمك، كما قطعت رحمي...».
ـ علي ابن الحسين× شدّ على القوم مرتجزاً:
أنا علي بن الحسين بن علي
نحن وبيت الله أولى بالنبي
والله لا يحكم فينا ابن الدعي
يمكن أن يستشفّ من هذه الحوارية خرق لقاعدة المناسبة، عبر انزياح الرمز إلى مقاصد كامنة يمكن إدراكها من سياق المقام، فقد ظهر ذلك الخرق ـ استخفافاً لسيميائية البكاءـمقروناً بالتركيب الذي يلوح لحكم متداول فقهياً وعرفياً. إذ علي بن الحسين×يسأل أباه طلب الإذن في البراز، ولكن تجاوز جواب الإمام الحسين×في ظاهره موضوع المحاورة، وبذلك عُدّ استخفافاً لمبدأ المناسبة، بتقديم أخبار لا تتوافق مع سطحيّة الحوار، إذ مقتضى قاعدة المناسبة أن يجيب الإمام× بنعم أو لا؛ إلّا أنّه خرق القاعدة بسيميائية البكاء التي استلزمت الموافقة، وأيّ موافقة تلك التي تضمّنت:
1 ـ الحسرة والألم على استشهاد ولده.
2 ـ شدّة تعلّق الإمام× بجدّه رسول الله’، وأنّه بفقد ولده سيكون الألم مضاعفاً، فإنّه بذلك يكون قد تضاعف عليه فقدان جدّه وولده الذي طالما كان يُذكّره به، والذي يرشّح هذا القصد، قوله×: «قد برز إليهم غلام أشبه النّاس خلقاً وخُلُقاً ومنطقاً برسولك، وكنّا إذا اشتقنا إلى نبيّك نظرنا إليه».
3ـ تضمّنت بيان المكانة الكبيرة لولده علي بن الحسين (الأكبر)× في أهل بيته وعند أبيه بشكل أكثر وأعمق، وما يعضد هذا الرأي قوله×: «يا بني، على الدنيا بعدك العفاء، وخرجت زينب بنت فاطمة‘، وهي تقول: وا أخاه، وانكبّت عليه، فأخذ بيدها الحسين× وردّها إلى الفسطاط»[414]. وهنا أطلق الإمام×المعنى الحرفي للخبر، وأضفى عليه معنى مستلزماً عندما ضمّنه تلميحاً بالإذن للبراز، مستعملاً الفعل اللّغوي المباشر، الذي دلّت عليه قرينة صيغة فعل (برز) لينجز فعلاً غير مباشر خرج إلى الرخصة وإعطاء الإذن في البراز لحظة التلفّظ بالفعل المباشر، وليس يخبر عن فعلٍ أنجزه في الماضي[415]. كما تشير القرينة البنيويّة حرف العطف (ثمّ) ـوهي من الاستلزام اللّغوي العامـإلى استلزام الترتيب مع مرور مدّة زمنية، تخلّلها انفصال ما بين الدعاء الذي سبقها، ثمّ التوجّه إلى العدوّ بالصياح، الذي يقتضيه السياق المقامي لما سيلقاه فلذة كبده، بدليل قوله: (قطعت رحمي، قطع الله رحمك) مع تضافر تلك القرائن السياقية التي أكّدت معنى الاستشهاد لعلي الأكبر، ما جعله يشدّ على القوم بعزيمة صلبة وعقيدة راسخة.
ومرّة أخرى يطالعنا خرق قاعدة المناسبة ـحوارياًـبالوسيلة نفسها عبر آلية البكاء التي سبقت الاستغاثة (وا غوثاه) والتحيّر الذي أُجبر على إظهاره أمام علي الأكبر، وهو أبيُّ الضيم، ولكن توجد مسوّغات عدّة لهذا الخرق:
أولاً: مع أنّ الحسين×إمام معصوم، إلّا أنّ هذا المقام والمنزلة لا يبعده عن عاطفة الأبوّة، فهو قد بكى رحمة ورأفة على الأعداء من دخول النار، فكيف به على ريحانته تنتاشها الرماح والسيوف. كما أنّ الإمام× مضطرّ لإظهار حالة الاستغاثة والتحيّر هذه؛ ليخفّف عن ابنه الذي جاء يستنجد بشربة ماء يتقوّى بها على الأعداء بعد أن أجهده ثقل الحديد، وما أسهلها من طلبة، لكن يبقى السؤال قائماً: لماذا لم يقدّم شربة من الماء لولده؟ وهذا ما أخرج الاستغاثة والتحيّر إلى مقاصد:
أ ـ إخبار الإمام×ولده بأنّه سيستشهد عطشاناً بين يدي الله سبحانه؛ فذلك أعظم أجراً وأعلى مقاماً، وهو ما أراده الإمام×لنفسه، فاستقبل عليُّ الأكبر إخبار أبيه بنفس راضية.
ب ـ إستغاثة الإمام× بقوله: من أين آتيك بالماء؟ تشير إلى أنّ السبب الطبيعي لوجود الماء كان متعذّراً عليه. وهو ما دعى علي الأكبر بأن يلوّح للإمام×بالاعتذار، إذ كان بإمكانه أن يقدّم المزيد من الفتك بالأعداء. فما كان من الحسين×إلّا التضامن معه، حيث لم يجد بدّاً من أن يشجّعه، ويوجّهه بالفعل اللّغوي الذي دلّت عليه صيغة فاعل (قاتل) وافعل (اصبر)، بعد ما استلزم منه البشارة لولده علي الأكبر بالحصول على الجائزة الكبرى (الشهادة) بقوله: «فما أسرع الملتقى بجدّك محمد’، فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبداً».
وعند التأمّل والتمعّن في سياق المقام ومجريات هذه الحوارية، يتبيّن أنّ طرفي الحوار لم يتوقّف قصدهما عند الدلالة الحرفية للملفوظات، فالمقام التحاوري وظاهر الخبر لا يتوافق مع دلالة المحاورة التي جرت مع علم علي الأكبر، بأنّ أباه أشدّ عطشاً منه، وأنّ كلام علي الأكبر لم يُرد به مجرّد الإخبار مثلما اتضح.
ثانياً: مما يقارب هذا الخرق «يا قوم، إن لم ترحموني فارحموا هذا الطفل، فرماه رجل منهم بسهم ذبحه، فبكى الحسين×، وقال: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا»[416].
يُثير المنهج هنا أسئلة كثيرة، منها: لماذا الإمام× عرّض الطفل للقتل؟ مع أنّه يعلم خطورة الموقف، وحقيقة هؤلاء القوم، الذين أشار اليهم عند أوّل خروجه في مسيرة الإصلاح بـ(عسلان الفلوات)؟! سواء أكان يودّع الطفل أم أخرجه ليطلب له الماء. ولهذا الخرق مسوّغات عدّة:
أ ـ ترك الامام× مجالاً لاحتمال نسبة ولو واحد من ألف؛ لاتعاظ هذا الجمع الغفير الذي احتشد لقتال الحسين× من أهل الكوفة، والذي بلغ ـبحسب بعض المصادرـثلاثين ألف جندياً. وهو فعلا ما وقع، حيث اختلف العسكر فيما بينهم، فقال بعضهم «إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار» وقال آخرون: «لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية».
ب ـ قتل جميع أصحاب الإمام وأخوته، بل لم يبق أحد مع الحسين×، لا سيما بعد مقتل ساقي العطاشى أخيه العبّاس×.
ج ـ شدّة عطش الطفل الذي جفّ صدر أمّه من اللبن.
د ـ استثمار الإمام الحسين×لأيّة فرصة من شأنها أن تكون حجّة له على القوم؛ فمع أن الأصل هو افتراض طاعته المطلقة كإمام، إلا أنّ ذلك لا يعني تجرّده عن العواطف والمشاعر الأبوية[417].
أمّا أهم المقاصد التي يمكن أن تستجلى من استنطاق النصّ الحاكي عن عطش الطفل الرضيع؛ والذي جاء محمّلاً بشحنتين، فهي:
المقصد الأوّل: المعنى القضوي، وهو الدلالة الحرفية لعناصر التركيب، وهي الإخبار بعطش الطفل.
المقصد الثاني: المعنى المستلزم، وهو استعطاف القوم في طلب الماء للطفل، وهذا استلزم ضمنا الإجابة عن كل الإشكالات المطروحة من قبيل: لماذا لم يُبعد الإمام الطفل الرضيع عن ساحة القتل على فرض توديعه أو الاستسقاء له، وهو يعلم أنّهم لن يرحموا أيّ مخلوق ينتمي لآل محمد’؟ 2. حرملة كان قريباً من الحسين×، لمَ لم يسدّد السهم على الحسين×؟ 3 لماذا لم يضع إبهامه في فم الرضيع كما كان يفعل جدّه’ معه؟؛ تلك الإشكالات التي جاءت بشكل مقاصد ضمنية عدّة، منها:
أ ـ أراد الإمام إقامة الحجّة على الأعداء، وترك باب الرحمة مفتوحاً على مصراعيه حتى آخر نفس من حياته الشريفة. فقد حاول إثارة ولو الشيء اليسير المتبقي في قلوبهم وأحاسيسهم[418]. إذ بقتلهم الطفل يثبت بالعيان والوجدان، قتلهم للأطفال والعزّل، وعلى أكثر من مرأى؛ أي: أمام أفراد الجيش المعادي نفسه، وأمام الجيل المعاصر للحسين×، وكذا أمام الأجيال المتأخّرة عنه. وبذلك تكون وثيقة موقّعة بالدم، تشهد على عظم جريمة القوم. إذ لم يكن عند الحسين×آنذاك قرطاس، يدوّن فيه الوقائع، فسطّرها على صفحات الهواء بخطابه الحيّ، حيث حصل التمحيص والاختبار آنيّاً، فضلاً عن إقامة الحجّة على المدى القريب والبعيد، وعليه فإنّ الحسين×رأى أنّ إقامة الحجّة أمام الأعداء فيها مصلحة أكيدة، ما جعله يقدّم ولده الرضيع فداءً لتلك الحجّة، وهذا أمر مقنع وجداناً؛ لأنّ ما حصل من فضيحة هؤلاء لم يكن له مثيل[419]، كما أنّ الحسين× وأصحابه، قصدوا زيادة بصمة الدم ورقعتها في واقعة كربلاء، وهذه المقصديّة يمكن أن نلمسها بمستويات[420]:
المستوى الأوّل: على مستوى الكلمات، فقد وردت عبارات قُصِد بها التصميم على الشهادة، وأوّلها أقوال الإمام الحسين×، من قبيل: (ألا وأنّ الدعي ابن الدعي...) (هيهات من الذلة...) (الموت أولى من ركوب العار...) (ليرغب المؤمن في لقاء الله محقاً...) (النّاس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم...) (لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل... ولا أقرّ إقرار العبيد...) وغيرها الكثير[421].
المستوى الثاني: على مستوى الفعل والسلوك، فقد وضع يده تحت منحر عبد الله الرضيع، ورمى به نحو السماء، وهذا بحدّ ذاته فعل يستلزم كثيراً من المقاصد، منها: أنّ هذا الدم هو بعين الله[422]، وهو ما حدث أيضاً حينما أُثخن بالجراح×، حيث أخذ يخضب لحيته، ويقول «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله، ورفع رأسه إلى السماء، وقال: إلهي، إنّك تعلم أنّهم يقتلون رجلاً ليس على وجه الأرض ابن نبيّ غيره، ثمّ أخذ السهم فأخرجه من قفاه، فانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده على الجرح، فلمّا امتلأت رمى به إلى السماء، فما رجع من ذلك الدم قطرة، وما عرفت الحمرة في السماء حتى رمى الحسين× بدمه إلى السماء، ثمّ وضع يده ثانياً، فلمّا امتلأت لطّخ بها رأسه ولحيته، وقال: هكذا أكون حتى ألقى جدّي رسول الله، وأنا مخضوب بدمي»[423].
ثالثاً: ومما يقارب خرق هذه القاعدة الحوارية التي دارت بين السيدة زينب‘ وبين ابن مرجانة، حينما سألها متهكّماً شامتاً.
ـ فقال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟
ـ فقالت‘: ما رأيت إلّا جميلاً، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم، فتحاجّون إليه، وتختصمون عنده، فانظر لمن الفلج يومئذٍ، ثكلتك أمّك يا ابن مرجانة.
ولهذا الخرق في قاعدة المناسبة حوارياً، من الظروف والمسوّغات التي سبق ذكرها[424]، وبعد إعادة النظر والتدقيق في سياق المقام وظروف هذه الحوارية، يتبيّن أنّ طرفي الحوار لم يتوقّف قصدهما عند الدلالة المعجمية للملفوظات، فالمقام التحاوري وظاهر الخبر لا يتوافق معدلالة المحاورة التي أراد ابن مرجانة منها أكثر من الاستفهام؛ وذلك لأمور عدّة:
ـ طبيعة السؤال الذي يخصّ استخباراً عن أنباء حزينة للعقيلة.
ـ المنزلة العظيمة لأهل بيتها في الإسلام والمجتمع وعندها، وهم سبط النبي الأكرم’، وأهل بيته ^. ولتحليل الحوارية وفقا للتوجيه التداولي؛ نقول:
أ ـ لا يمكن أن يسمح سياق المقام بأن يكون قصد المستفهم في قولة عبيد الله ابن زياد (كيف ـ صنع الله ـ أهل بيتك)، هو من قبيل سؤال الجاهل، وبعبارة أخرى: أراد الدلالة الحرفية من سؤاله، بل لعلّه خرج لأكثر من قصد:
1ـ إظهار الشماتة والتشفّي من أهل البيت^، بعد أن أهانته السيدة‘، واستحقرته من خلال عدم الاكتراث بكلامه.
2ـ إيهامعامّة النّاس بأنّ القتل حصل من الله، وأنّهم استحقّوا هذا المصير نتيجة خروجهم على يزيد بِعَدّه خليفة، وهذا بزعمه يضفي شرعيّة لقتلهم.
3ـ تحجيم أمر الجريمة التي ارتكبوها، من خلال سؤاله عن أهل بيتك، وهذا ما استلزمه السياق الحواري، فضلاً عن لفظة (أهل بيتك) وكأنّ قيام الإمام×بوجه السلطة الأموية وظلمهم مسألة شخصيّة، ومسألة يتوارثها القوم، ومن هنا جاء الخرق لقاعدة المناسبة عندما تجاوزنا بمعيّة المحاور الدلالة الحرفية للمنطوق إلى قصد يُفهم من تضافر مجموعة قرائن مقامية، ولذا سنجد كيف جاء الردّ من قبل السيدة‘، وعلى خلاف ما كان يتوقّع ابن مرجانة.
ب ـ مقابلة قولة السيدة زينب‘ بقولة ابن مرجانة:
وهنا تبدّدت تطلّعات ابن مرجانة، وتحوّلت نشوة النصر إلى هزيمة الانكسار والخيبة، ما جعلته يفقد صوابه فـ(استشاط غضباً)[426]. إذ حاشا السيدة‘، وهي العالمة ربيبة البيت العلوي، أن تقول لغطاً أو خطلاً. نعم، حصل الخرق منها في قاعدة المناسبة؛ لأنّ المتوقّع من الطرف الآخر هو الأمر الطبيعي الذي سبق ذكره، إلّا أنّها ـ بعد أن استثمرت الظروف ومسوّغات الخرق ـ رامت من وراء هذا الخرق في قاعدة المناسبة مقاصد عدّة:
1ـ بيّنت أنّ ما حصل لقومها وأهل بيتها الذين حاول تحجيمهم وحصرهم بموروث الدم والعشيرة، إنّما هو بعلم الله وبمشيئته وإرادته، وكل ما جاء من عند الله فهو خير، وهي بذلك تُلوّح لقوله تعالى: (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)[427] وقوله: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[428]، فلا شكّ أنّ كل ما جاء من عند الله جميل.
2ـ قصدت خلاف ما أرد ابن زياد، حيث أراد بقوله «كيف رأيتي...» الرؤية البصرية، من سفك لدماء أهل بيتها، وأنصارهم، وترويع للنساء، وحرق للخيم، وإهانتها بعد أن كانت لا يُرى لها ظلّ ولا يُسمَع لها صوت[429].
3ـ بيّنت أنّ لكل أجل كتاباً، وهؤلاء برزوا إلىآجالهم التي كتبها الله عليهم.
4ـ هدّدته بقيام محكمة عادله، ستجمعه بجميع الشهداء الذين برزوا إلى مضاجعهم، حيث تضمّن قولها التلويح إلى قول النبي’: «عجّلوهم إلى مضاجعهم» وهو دليل على الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن[430]، وهذا ما أكّده الإمام الحسين× حينما سأل: ما اسم هذه المنطقة؟ فقالوا: كربلاء[431].
5ـ كشفت له وللسامعين حقيقة ما سيؤول إليه مصيرهم المشؤوم في الدنيا قبل الآخرة، ثمّ دعت عليه بالهلاك؛ لجرأته على الله ورسوله.
رابعاً: ومما يقارب خرق قاعدة الملاءمة حوارياً، الحوارية التي دارت بين زهير بن القينE وسيّدنا العبّاس× ـ بعد أن رجع مغتاظاً من نداء الشمر بإعطائهم الأمان له ولإخوته ـ حيث قال زهير: «قد ادّخرك أبوك لمثل هذا اليوم، فلا تقصِّر عن حلائل أخيك وعن أخواتك، قال: فارتعد العبّاس×، وتمطَّى في ركابه حتى قطعه، وقال: يا زهير، أتشجِّعني في مثل هذا اليوم؟! والله، لأرينّك شيئاً ما رأيته قط، قال: فهمز جواده نحو القوم حتى توسَّط الميدان»[432].
لعلّ أبرز مسوّغ دعا زهير لخرق قاعدة الملاءمة، هو كثرة الجيوش والعسكر المحيطة بمخيم الإمام الحسين×، مع قلّة الناصر. فجاء القصد الذي استلزمه كلام زهير حاكياً عن استنهاض كل طاقات أبي الفضل العبّاس× الكامنة في داخله، عبر تذكيره بكلام أبيه علي بن أبي طالب×، وقديستلزم ـأيضاً ـ جهل زهير بحقيقة شجاعة وحماسة العبّاس×؛ كون زهير كان منشغلاً بالتجارة ومعتزلاً للسياسة، الأمر الذي جعل العبّاس×يرتعد غضباً حتى قطع ركابه، واستنكر على زهير أن يذكّره أو يشحذ همّته لنصرة أخيه الحسين× وحريمه، فهو شبل علي بن أبي طالب×، مما دفعه للنزول وسط الميدان مع وجود كثرة العسكر واحتدام الأسنّة؛ لكي يطمئن زهير أكثر، بأنّ ما في داخل العبّاس× من شدّة وشجاعة تكفي لأن تكون سبباً لما صنعه أعداؤه بجسده الطاهر بعد استشهاده، وهذا ما فعلوه مع الحسين وعلي الأكبر÷.
خامساً: مما يقارب أيضاً خرق هذه القاعدة، هو ما حصل في حواريّة المبعوث الذي كان أحد المنتمين للركب الحسيني بشهادة الإمام الحسين× (من لحق بي استشهد، ومن تخلّف لم يدرك الفتح)، حينما وجّه سؤاله ليزيد بعد أن أمر جلاوزته بقتله، مخافة الفضيحة؛ قائلاً: أتريد أن تقتلني؟ ولهذا الخرق مسوّغات:
1ـ لفت انتباه يزيد عبر استفهامه، إلى أنّ بينهم معاهدة سلام.
2ـ محيط الحوارية؛ حيث كان يكتظ بالوجهاء والمستشارين، ومنهم سرجون النصراني مولى يزيد، الذي قد يكون على علاقة وثيقة به.
3ـ دفع المبعوث يزيد للإقرار بجريمته عبر الاعتراف علناً؛ لقطع أيّ مجال في التماس أيّ عذر له.
أمّا مراد المبعوث الذي قصد إيصاله في ضوء الخرق، فقد انطوى على معنيين:
المعنى القضوي: وهو الدلالة الحرفية لعناصر التركيب.
المعنى المستلزم؛ الذي خرج إلى قصد:
أـ الإنكار والتعجّب من حماقة يزيد، فهو بفعله هذا ينقض بنود معاهدة السلام التي وقّعتها السلطة الأموية مع الحكومة البيزنطية[433].
ب ـ الإفصاح عما رآه المبعوث في منامه، بأنّه قد رأى النبي’، وأنّه بشّره بالجنّة، وتعجّبه من هذه البشارة التي لا يعرف سببها. وبعد أن عرف سببها، فهو ملزم مقامياً أن يخبره بما سيؤول إليه أمره، وفي إخباره ليزيد قصد:
ـ التعريض بإسلام يزيد، فضلاً عن إيمانه وعدالته.
ـ زيادة الحسرة والإساءة في قلب يزيد.
ـ إعلان إسلامه أمام يزيد، بعد أن عرف أنّ البشارة كانت بسبب موقفه من الرأس الشريف.
الاستلزام الحواري في ضوء قاعدة الطريقة
احترام قاعدة الطريقة (الكيفيّة أو الجهة)
ينصّ احترام هذه القاعدة على توخّي الوضوح، والترتيب، والإيجاز في الكلام، والابتعاد عن الالتباس، والغموض، والاضطراب، والإطناب أو الإجمال.
ويرى فان ديك «بدلاً من استعمال عبارات مثل اعتبار جهة النظر، فإنّ زيادة اختصاص الوصف الدلالي للشروط المقتضاة من السياق يمكن أن تصاغ في مصطلح جامع هو موضوع التحاور»[434] بمعنى أنّ الترتيب الحاصل بواسطة التعاطف أو العطف على سبيل الجمع من كلا الطرفين، لا يمكن أن ينسب في ذات الوقت إلى الموضوع المتحاور فيه نفسه؛ أي: أنّ موضوع التحاور يمكن أن يعرف من الوجهة الدلالية بأنّه مجموعة من القضايا[435]، فهناك العديد من المقوّمات التي تتحكّم في تحديد الوجهة الدلالية للمدلولات بين المتحاورين، من قبيل العادات والمعتقدات والمعارف المشتركة التي يمتاح بواسطتها المخاطب المقصود الضمني والمستلزم حوارياً من المتكلّم[436]؛ إذ أنّ الغاية من صياغة الخطاب التداولي وتحليله ـسواء ما وافق مبدأ التعاون والقواعد المتفرّعة عنه أم لاـهو الإبلاغ، وطرق الخطاب الإبلاغي ليست حكراً على طريق أو أسلوب واحد، فمنها: الخطاب المباشر، ومنها: غير المباشر.
حدّد طه عبد الرحمن الخطاب الحقيقي الذي ينبني على مقاصد أربعة، بمقصدين تخاطبيين، هما[437]:
ـ أن يكون الخطاب موجّهاً إلى آخر متلقٍّ، يحدّده ويختاره المتكلّم.
ـ أن يقصد المتكلّم بخطابه إفهام المتلقّي بمقصود معين[438].
وعليه؛ يكون متعلق هذين المقصدين معرفيا؛ هو[439]:
ـ قصد الادعاء: المراد منه أنّ اللفظ لن يكون خطاباً حقيقياً إلاّ إذا كان الناطق به معتقدا صراحة بما يقول، وعند الحاجة على تمام الاستعداد لإقامة الدليل عليه.
ـ قصد الاعتراض: مفاده أنّ المنطوق لا يكون خطاباً حقيقياً حتى يكون له حق مطالبة الناطق بالدليل على ما يدّعيه، وإلّا فإنّه يكون دائم التسليم بما يدّعيه الناطق، أو عديم المشاركة في مدار الكلام.
وكلا هذين القصدين هما روح التفاعل الحجاجي؛ «إذ حدّ [الحجاج] أنّه كل منطوق به، موجَّه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة، يحقّ له الاعتراض عليها»[440].
إنّ فهم الخطاب الموجّه إلى الآخر لا يتوقّف على استخراج المعاني من عناصر التركيب المعجمية فقط، إذ لا بدّ من الاستعانة بعمليات تنبني أساساً على التفاعل الحجاجي بين الذات المستدلِّة والذات المستدلّ لها[441]، فعلى المتكلّم أن يخضع كلامه لمجموعة من العوامل الثقافية والاجتماعية، والمعارف المشتركة، وغيرها من المقتضيات التي تُسهم من قريب أو بعيد في تحقيق قصد الخطاب، فهو منذُ البداية «يعتمد على بناء أقواله بطريقة تستحضر الكيفيّة التي يتوقّع أن يؤوّل بها المخاطَب هذه الأقوال»[442]. فالمخاطِب يقصد ما يضمره كما يقصد ما يظهر، أي: أنّه يقصد كل ما يقوله، ويتوقّع الخطوات التي يقوم بها المتلقّي سابقاً، بغية تحقيق فهم المخاطِب وإدراك قصده الحقيقي، وبعبارة أخرى: إذا كانت كفاية المخاطِب التداولية تتجلّى في صناعة الخطاب، فإنّ كفاية المخاطَب التداولية تتجلّى في تأويل الخطاب للوصول إلى مقاصد المخاطِب وإدراك حججه[443]؛ لذا خطاب المسيرة الحسينية خطاب مرتبط بسياق حالي، والمراد الجدّي لا يفهم إلّا في إطار التركيب وسياق الحال وغرض المتكلّم وقصده من الكلام[444].
توخّي الوضوح والترتيب في متوالية الملفوظات
أولاً: خطاب الإمام الحسين لرؤساء الأخماس:
تتجلّى هذه القاعدة في ضوء خطابات المسيرة الحسينية، ضمن كتابٍ أرسله الإمام ×إلى رؤساء الأخماس في البصرة، وقد استعمل فيها الخطاب المباشر وغير المباشر، جاء فيه قوله×: «أمّا بعد، فإنّ الله اصطفى محمداً’ من خلقه، وأكرمه بنبوّته، واختاره لرسله، ثمّ قبضه إليه، وقد نصح لعباده، وبلَّغَ ما أُرسل به، وكنّا أهلَه وأولياءَه وأوصياءَه وورثَتهُ وأحقَّ النّاس بمقامه، فاستأثر علينا قومُنا بذلك فرَضِينا، وكرِهنا الفرقة، وأَحْبَبْنا العافية، ونحنُ نعلمُ أنّا أحقُّ بذلك الحقِّ المستحقِّ علينا ممَّن تولَّاهُ، وقد بعثتُ رسولي إِليكم بهذا الكتاب، وأَنا أدْعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيّه’، فإنَّ السنّة قد أُمِيتت، وأنَّ البدعةَ قد أُحييت، فإنْ تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله»[445].
وهذا الخطاب بشقّيه المباشر وغير المباشر، جاء موافقاً ومحترماً لقاعدة الطريقة التي توخّت الوضوح، والترتيب، والإيجاز، بغية التأثير والإبلاغ. إذ من الأمور التي تجعل الخطاب المباشر أبلغ وقعاً وأدقّ ضبطاً ما يأتي[446]:
ـ بيان الحقائق العقائدية والعبادية، كقضايا الإيمان بالله ورسوله والعدل...
ـ توعية النّاس وتحذيرهم من جميع ما يداهمهم من مخاطر.
ـ إعلان المبادئ العامّة التي تخدم مصالح الإسلام والمسلمين.
ـ بيان الأسس والمبادئ التي تتبنّاها أيّ انتفاضة أو تظاهرة أو ثورة.
ـ إعلان السمات، والأهداف العامّة والخاصّة للثورة أمام النّاس، كما فعل سيّد الشهداء×بقوله: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، إنّما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي...».
كل هذه وغيرها دعت الإمام×للالتزام بترتيب خطابه، فقد بدأ:
1ـ بيان مقام الرسول محمد’، وبيان أفضليّته على الخلق من خلال اصطفائه وتكريمه بالنبوّة، ثمّ تكليفه بالرسالة، ثمّ قبضه إليه.
2ـ بيان سيرة النبي’ في تبليغه للرسالة، وأداءه للتكليف الشرعي تجاه العباد.
3ـ تعريجه على استظهار مقامهم من النبي’، وبيان علاقتهم به، وذكر سماتهم «كنّا أهله وأولياءه وأوصياءه».
4ـ انتقاله إلى بيان أحقّيتهم بوراثة مقام النبي’ بعد انتقاله للرفيق الأعلى.
5ـ بيان مظلوميتهم؛ من سلب لحقوقهم الشرعية التي استأثرها عليهم القوم. حيث استلزمت لفظة القوم معنى غير معناها القضوي الحرفي الذي دلّ عليه اللفظ، فقوم: الرجال دون النساء، لا واحد له من لفظه. قال زهير بن أبي سلمى في هجاءه لقوم[447]:
|
وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء |
وقال تعالى: (لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ)[448]، وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع؛ لأنَّ قومَ كلِّ نبيٍّ رجالٌ ونساء[449].
6ـ بيّن مدى سماحتهم وقبولهم بذلك الاستئثار وكراهيّتهم لفرقة المسلمين، مع علمهم بأحقّية حقّهم من غيرهم.
7ـ ثمّ أتى على ذكر المبعوث إليهم، الذي ينقل دعوته واستنصاره على الظلمة.
8ـ بعد أن رتّب جميع الأمور التي تثبت أشرفيّة رسول الله’، الذي هو من أهل بيته ووليّه ووريثه، وأحقّيته بتولّي أمور المسلمين، تحوّل خطابه×إلى خطاب غير مباشر، مع بقاء القصد المستلزم على ايضاحه، وترتيبه، وايجازه بعيداً عن اللبس، وذلك لسببين:
الأوّل: الحجج والاستدلالات التي ساقها إلى المتلقّي من بداية خطابه.
الثاني: المفردات اللّغوية ذات المعاني المعجمية التي لا تنفكّ استلزاماتها عن دلالتها المعجميّة، من قبيل أدوات العطف (الواو، أو، الفاء، ثمّ) وبعض الألفاظ التي تدلّ على العموم كـ(ال العهدية) ولفظة (قوم) التي دلّت على الرجال دون النساء.
وضمن مقصديّة التضامن، يعتمد الإمام× على آليات الخطاب الإجرائي، المستفاد من قاعدتي التودّد والتعفّف، وباعتماد الإشارات التقريبية من المتلقّي حين بدأ خطابه بوصف النبي’، ليكشف بعدها عن علاقته بالنبي’ هو وأهله الطاهرون، ولا يقصد نفسه فقط، ولذا جاء بإشارات الجمع؛ للتدليل على القرب المعنوي والمادّي بين النبي’ وبينهم أهل البيت^، وهي قوله: «وكنّا أهلَهُ وأولياءَه وأوصياءَه، وورثَتهُ، وأحقَّ النّاس بمقامهِ». حيث اكتفى النصّ بنفسه ليأتي موظّفاً للمعنى الحرفي المستلزم من الفعل الكلامي غير المباشر، فهو خطاب واحد بشحنتين إجرائيتين (الإخبار ـ الطاعة). ثمَّ ينتقل الخطاب ليضع المتلقّين وجهاً لوجه أمام الغاية التي سيق من أجلها، منتقلاً تداولياً إلى توظيف إشاري جديد، وهو الاستعمال الإفرادي لضمائر التكلّم، جامعاً بين اللواصق واللواحق من طريق الكلمات (قد بعثت، رسولي، وأنا، أدعوكم، قولي، أهدكم) التي تنطوي على إشارات شخصيّة تحبّبية تنوّعت بين الإفراد بصيغه (الضمير أنا، وتاء الفاعل، وياء المتكلم)، فضلا عن صيغة الجمع (أدعوكم، وأهدكم) التي اعتمدها منجز الخطاب بغية تحقيق قصده، وهو التضامن بين طرفي الخطاب. ثم يعمد الإمام×ثانية إلى التأكيد على قصديّة التضامن عبر وسيلة أخرى، وهي من أهم وسائل القصديّة، سواء كانت تضامنية أم غيرها، ألا وهي الفعل الكلامي غير المباشر الذي يتحقّق من خلال الجمل التقريرية كقوله: (وقد بعثتُ رسولي إِليكم بهذا الكتاب) فهنا فعل قضوي واحد، وهو المعنى الحرفي للتركيب القضوي المتمثّل:
- بإرسال حامل هذه الرسالة.
- والدعوة لكتاب اللهI والسنّة الشريفة، وسبب الدعوة هو موت السنّة وإحياء البدعة، حيث استلزمت قصده من الخطاب ثلاثة أفعال إنجازية، هي:
أ ـ إرسال الرسول ليس هو المعنى المقصود، إنّما لازمه وهو ما يحمله من دعوة ضمنية لنصرة الحسين×والالتحاق به؛ لأنّه المُمثّل الشرعي لكلام اللهI والسنّة المطهّرة ـ التي حاولوا طمسها بعد رحيل جدّه وأبيه ـ المتمثّلة به×، بدليل قول النبي الخاتم’ «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي»[450].
ب ـ ليس المقصود من الدعوة قراءة الكتاب والسنّة، إنّما المقصود نصرته×، واستنهاضهم للأخذ بحقّه المسلوب، الذي تجسّد بتعطيل كلٍّ من الكتاب والسنّة، بدليل ما ورد عن النبيّ’ (مَن رأى منكم سُلطاناً جائراً...).
ج ـ ترك لهم حرّية اتخاذ القرار الذي يريدون، من دون أن يقحمه ـقصدياً ـ بخياراته الخطابية على وفق قاعدة التخيير. ثمّ أنّ قوله×: «فإنْ تسمعوا قولي أهدكم إلى سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله» الذي ختم به خطابه، قد أطلق فيه أسلوب الشرط، حيث يعطي هذا التركيب السياقي مدلولين مقصودين لمنجز الخطاب:
الأوّل: قصديّة التضامن أوّلاً وبالذات، التي تحقّقت من طريق أسلوب الشرط والتعبير الإطرائي، الذي ختم به خطبته بالسلام والرحمة، بمعيّة قاعدة التودّد التي تمثّلت بعدم الإلحاح من قبل الإمام×، أو فرض نفسه على المتلقّي.
الثاني: المدلول الالتزامي، أو ما يسمّيه الأصوليون مفهوم الجملة الشرطية التي ختم بها الإمام الحسين× كتابه، والتي اعطّت فهماً مغايراً لما عليه السياق الشرطي، وهذا الفهم هو المستلزم من الكلام، وهو نفس قصده. فالمقصود ليس لازمه الفعل القضوي (تسمعوا) ذو الدلالة الحرفية الناشئة من ائتلاف دلالة عناصر التركيب.
ثانياً: تحذير أهل الكوفة من سَخط الله والتوجّه لطاعته:
يمكننا مقاربة احترام هذه القاعدة بغية تحقيق تمام القصد المراد من لدن الإمام×، والمتمثّل في توجيه القوم نحو الحذر من سخط اللهI، والتوجّه لطاعته، الموجب لعدم هلاكهم في الدنيا، والنجاة من الخزي والعذاب الأليم في الآخرة.
لجأ الإمام×إلى توخّي الوضوح والترتيب والإيجاز بقوله×: «أقولُ لكم: اتَّقوا الله ربَّكم ولا تَقْتُلونِ، فإِنَّه لا يَحِلُّ لكم قتلي، ولا انتِهاكُ حُرمتي، فإِنّي ابْنُ بِنت نَبيِّكم وجدَّتي خديجَة زوجَة نبِيِّكم، ولعلَّهُ قدْ بلغَكم قولُ نبِيِّكم محمَّد’: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة ...، فإن صدّقتموني بما أقول، وهو الحق، فوالله، ما تعمّدت كذباً منذ علمت أنّ الله يمقت عليه أهله، وإن كذّبتموني فإنّ فيكم من الصحابة مثل جابر بن عبد الله، وسهل بن سعد، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، فاسألوهم عن هذا، فإنّهم يخبرونكم أنّهم سمعوه من رسول الله، فإن كنتم في شكّ من أمري، أفتشكّون أنّي ابن بنت نبيّكم؟ فوالله، ما بين المشرقين والمغربين ابن بنت نبيّ غيري، ويلكم، أتطلبوني بدم أحد منكم قتلته؟ أو بمال استملكته؟ أو بقصاص من جراحات استهلكته؟ فسكتوا عنه لا يجيبونه، ثمّ قال×: والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفرّ فرار العبيد، عباد الله إنّي عذت بربّي وربّكم أن ترجمون، وأعوذ بربّي وربّكم من كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال له شمر بن ذي الجوشن: يا حسين بن علي، أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ما تقول، فسكت الحسين»[451].
رتّب الإمام×كلامه عبر خطابه المباشر من استعمال فعلين لغويين مباشرين، فعل الأمر الصريح، والدالّة عليه القرينة البنيويّة (أفعل)، وفعل النهي، والدالّة عليه (لا الناهية، والفعل المضارع: يحلّ)، ودلالتهما المباشرة الناتجة من المعنى القضوي، والذي يدلّ عليه المعنى الحرفي، ألا وهو طلب حصول الشيء والكفّ عن حصول الآخر على الفور أو التراخي، أمّا المعنى المستلزم (القصد) فهو ـكما أسلف البحثـدعوتهم لمخافة الله، ونهيهم عن معصيته المتمثّلة بقتله، وقد اكتفى النصّ بنفسه ـ ليأتي موظّفاً للمعنى الحرفي والمستلزم من الفعل اللّغوي المباشر، فهو خطاب واحد بشحنتين إجرائيتين ـ للأسباب الآتية:
1ـ إشارة إلى عظم مقام ومكانة كلّ من اتصل بالنبي محمد’، بقوله: «فإِنّي ابْن بِنْت نبيِّكم، وجدَّتي خديجة زوْجة نبِيِّكم»، سواء نسباً كان أم سبباً، وحتى في هذا السبب رتّب الأولى فالأوّلى بحسب مقام كلٍّ من بضعة النبيّ فاطمة ـصلوات ربّي عليها وعلى أبيهاـ، وأمّها خديجة بنت خويلد ـرضوان الله تعالى عليهاـ.
2ـ التذكير بكونهما؛ أي: الحسن والحسين÷ سيّدي شباب أهل الجنّة ما خلا النبيّين والمرسلين، وهذا بشهادة رسول الله’، وهو جدّه×.
إنّنا لو تأمّلنا فقرات الخطاب المذكور، لوجدناه حاكياً عن أحداث واضحة، متناسقة بعيدة عن الاضطراب؛ لأنّها متعاطفة ومضمومة بعضها إلى بعض، فضلا عن وجود علاقة بين الوقائع والحقائق، والأدلّة العقلية والنقلية المدلول عليها في الجمل الفرعية. كما عمد الإمام× في خطابهإلى أسلوب آخر من أساليب الخطاب، وهو ما يسمّى في ضوء منهج تحليل الخطاب التداولي بمبدأ التأدّب، ويتفرّع منه ثلاث قواعد تخاطبية بحسب رأي روبين لا كوف[452]:
1ـ قاعدة التعفّف: وهي قاعدة تستلزم عدم فرض المتكلّم نفسه على المخاطَب، بحيث تُلزمه ترك مسافة بينه وبين المخاطَب، فلا يقتحم خصوصيّته إلّا بإذنه، ويتجنب إثارته وحمله على فعل ما يكره، وإذا لزم الأمر الاعتذار منه بوساطة عبارات تحمل دلالات وجدانية، من قبيل أفعال القلوب.
2ـ قاعدة التشكيك: تستلزم هذه القاعدة عدم القطع أو الجزم في الكلام من خلال تجنّب استعمال أساليب التقرير، والتماس المتكلّم العون من أساليب الاستفهام أو الشرط، تاركاً للمخاطَب حرّية الاختيار واتّخاذ القرار، كما في قول الإمام الحسين×: «فإن كنتم في شكّ من أمري، أفتشكّون أنّي ابن بنت نبيّكم».
وقد تشبّث الإمام× على طول المسير بالتزام هذه القاعدة في خطاباته، سواء بفعل التشكيك ولفظه ـكما ذكرتـأم بالأساليب التي تحكيه. فمثلا ما استثمر×في قوله: «أتطلبوني بدم أحد منكم قتلته؟ أو بمال استملكته؟ أو بقصاص من جراحات؟» جاءت أساليبه موزّعة بين مبدأ التأدّب، وقواعد التخاطب الحواري في ضوء مبدأ التعاون واحترام قاعدة الكيف، حيث استُلزم منها إقناع المتلقّي بمخافة الله سبحانه، والسعي لنيل رضاه، من خلال طاعتهم أهل البيت^، وتجنّب سخط الله عليهم بتركهم قتله وانتهاك حرمته.
3ـ قاعدة الودّ: تقتضي هذه القاعدة إظهار الودّ والمحبّة للمخاطَب، كما تقتضي أن يكون المتكلّم في نفس رتبة المخاطَب، أو أعلى منها؛ لأنّ نجاح هذه المعاملة يتوقف على كون المتكلّم ذا مكانة أو سلطة أعلى من المتلقّي أو في الرتبة نفسها. وهي قواعد كلّية اجتماعية يفهمها المجتمع على اختلاف لغاته، وخير ما يجسّد هذه القاعدة قول الإمام الحسين×لأخيه العبّاس×: «يا عبّاس، اركب ـبنفسي أنتـيا أخي»[453]. حيث جاء خطاب الإمام× ـفي ضوء قاعدة التودّدـمشحوناً بالثناء والمديح والعاطفة الأخوية، وهو ما يمكن أن يدلّ عليه المعطى القضوي، لاسيّما حين دراسة الظروف السياسية والعسكرية التي اكتنفت الخطاب. فقد صُدّر هذا الخطاب ضمن ظروف وملابسات تقتضي أن تنبري شخصية مفاوضة مع المعسكر الآخر؛ لطلب استمهال القوم، وهو ما يناسب شخصيّة العباس×؛ لكن خطاب الإمام الحسين× لوّح إلى الخصائص العسكرية التي كانت تتمتّع بها شخصيّة العبّاس×بشكل ضمني، وراح يوظّف سبل التودّد العاطفي ـ مع ما يتمتّع به الإمام الحسين×من سلطة عليا دينية، متمثّلةً بإمامته للأمّة، وأخرى اجتماعية لكونه الأخ الأكبر ـ بين منجز الخطاب ومقصوده، لذا صار الخطاب طافحاً بمفردات المديح، وهي:
1ـ إنّ الخطاب رفع القيمة المعنوية للعبّاس×حينما قرنهابقيمة الحسين×، كما تدلّ عليه مفردة (اركب بنفسي) أي: نفسي فداء لك.
2ـ هذه الشهادة الحسينية المدلول عليها في الخطاب المبارك لا تستلزم المعنى الأساسي لعنصر الفداء، بل هي على نحو الحقيقة؛ لأنّ الحسين×بوصفه معصوماً لا يصف ما فوق المعنى، وليس في مقام المبالغة، وهو ما أجلى القيمة الحقيقية لأبي الفضل العبّاس× لدى الأئمة^.
إنّ هذه الأفعال اللّغوية المباشرة وغير المباشرة، التي تراوحت بين الخبرية والإنشائية، كلَّها جاءت بهدف التأثير في المتلقّي عبر مقصديّة الإقناع التي استلزمها تحديداً الفعل غير المباشر، إذ يقتضي أسلوب المحاججة تسلّسل الحجج من الأقوى فالأقوى، والابتعاد عن الغموض والاضطراب الذي تقتضيه قاعدة الطريقة.
فالفعل اللّغوي تحصّل من الاستفهام الحاكي عن القصد، فالمتكلّم يريد من المخاطب الاستعلام عن أمر لم يستقرّ عنده، وناتج هذا الحد هو قيامه على عناصر قولية ومقامية تمثّلت بالمتكلّم والمخاطب، وحال كلٍّ منهما، والظروف التي تكتنف السياق من حيث حصول الأمر المستفهم عنه أو عدم حصوله في علم كل منهما[454]. وقد تميّز أغلب الاستفهام الوارد في خطاب المسيرة الحسينية على أساس النصوص التي وُجّهت إلى المخاطب بانزياحه عن الاستخبار الحقيقي، الذي دخل في دائرة الخطاب فأنجز به أفعالاً لغوية غير مباشرة، تنوّعت بين التعجّب، والتقرير، والتوبيخ، والنفي، والأمر، وغيرها من الإنجازات اللّغوية المعقّدة التي قسّمها (سيرل) إلى قسمين: بسيطة ومعقّدة، والأخيرة تعني: الإنجاز الذي يقوم به المتكلّم بصياغة فعل قضوي مع القصد إلى دلالته الحرفيّة، بالإضافة إلى دلالته غير المباشرة، أي: دلالة مُدرَكة مقامياً، يكون المتلقّي حيالها أمام قوّتين إنجازيّتين لمنطوق قضوي واحد: قوّة إنجازيّة حرفيّة، وقوّة إنجازيّة مستلزمة[455].
أمّا القوّة الإنجازيّة الحرفية فتدلّ عليها القرينة البنيويّة (حرفية الاستفهام)، وأمّا القوّة الإنجازيّة المستلزمة فتخرج إلى جملة من المقاصد؛ منها:
1ـ قصد دفعهم للإقرار والاعتراف بقوله: «أفتشكّون أنّي ابن بنت نبيّكم؟».
2ـ التعجّب، كما هو حاصل من قول الإمام׫ويلكم، أتطلبوني بدم أحد منكم قتلته، أو بمال استملكته، أو بقصاص من جراحات»، حيثسلك الإمام×طرقاً عدّة لإيصال مقاصده عبر المقام التخاطبي الذي يَسِمُ الخطاب بطابع القصديّة، فاستثمر الطاقة التعبيرية للاستفهام في كشف سريرة أهل الكوفة، وتقلّبهم، ومعرفة أحوالهم، واختلاف أمزجتهم وأهوائهم، وهو أمر يستدعي الاستغراب والتعجّب والدهشة من تقلّب مواقفهم وتغيّرها، فهم يعرفون جيّداً أنّه ابن بنت رسول الله’، وابن إمامهم وخليفة المسلمين علي بن أبي طالب×، علاوة على كونهم قد استصرخوه وطلبوا نجدته، وكتبوا له يعاهدونه ويبايعونه على الخلافة، لكن سرعان ما سُلَّت السيوف عليه بعدما كانت معه؛ ما دفع الإمام×إلى محاججتهم بأسلوب الاستفهام. وستأتي بقيّة المقاصد التي ستتكفّل ببيانها باقي سياقات الخطاب في ضوء قواعد الحوار النمطية المعمّمة والمخصّصة[456].
تختلف هذه القاعدة عن أخواتها السابقات من قواعد مبدأ التعاون، إذ أنّها لا تهتمّ بما قيل، بل تهتمّ بالكيفيّة التي قيل فيها، أو نُطق بها[457]، وبما يراد إبلاغه للمتلقّي بأيسر الطرق وأوضحها.
إذاً فهي تنصّ على توخّي الوضوح في الكلام، والاستخفاف بها يستلزم الإخلال بالكيفية التي قيل فيها الكلام، وبوضوح المعلومات المعطاة في سياق الخبر، ومن ثمَّ يفضي خرقها إلى اختلال العمليّة الحواريّة، ممّا يتعيّن أن يحمل المحاوِر كلام مخاطبه على المعنى الخفيّ الذي يقتضيه المقام. ويأتي هذا الاستخفاف على مستويات عدّة، بحسب القولات الفرعيّة لهذه القاعدة[458]، وهو ما سوف نلمسه عند عرضنا لنماذج خرق مسلّمات هذه القاعدة على وفق قواعدها الفرعيّة في خطاب المسيرة الحسينية:
يحصل الالتباس القصدي في الخطاب عندما تحمل متوالية ما (جملة، أو مركّب اسمي، أو نصّ) معنيين أو أكثر، دون أن توجد قرينة تمنع ذلك[459]، وهذه المعاني يمكن أن تكون كلّها حقيقية على سبيل الاشتراك اللفظي، أو يكون بعضها حقيقياً وبعضها مجازياً، أو كلّها مجازيّة[460].
أرسل الإمام الحسين×كتاباً مقتضباً إلى أخيه محمّد بن الحنفية وأبناء عمومته من بني هاشم، جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى محمّد بن علي ومن قبله من بني هاشم، أمّا بعد، فإنَّ من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، والسلام»[461].
لقد وضع الإمام الحسين×مصلحة الأمّة نصب عينيه في هذا التحرّك العسير، مبتعداً عن الأنا الفردية التي تكتنف أرباب التحرّك السياسي أو العسكري، حيث أرخص من أجل ذلك نفسه وأهل بيته مع ما لهم من المكانة الاجتماعية والدينية.
كان أمل الإمام×أن تعي الأمّة مقدار هذه التضحية، فلا تتركه وحيداً طريداً، فراح يحفّز أبناءها من خلال استجلاء حقيقة ما سيقدم عليه، وأنّ ما عزم عليه إنّما هو خروج «لطلب الإصلاح في أمّة جدّي’»[462]، ممّا يستوجب نصرته والاستشهاد بين يديه، ولعلَّ ما قصده من قوله: «من لحق بي استشهد» المستفاد من الجملة الشرطية يشير إلى عدّة أمور؛ منها:
1ـ طلب النصرة من بني هاشم.
2ـ النصرة من الرجال لا من النساء؛ لأنّ الجهاد ساقط عنهن.
3ـ الالتحاق المطلوب سيقود حتماً إلى الشهادة.
4ـ اللحوق به مرهون بتوطين النفس على الشهادة، أي: البقاء برفقته إلى حين الشهادة، لا كما حصل عند بعض مرافقيه الذين تركوه لما رأوا حتميّة القتل.
5ـ الالتحاق يقتضي الإيمان بالقضية الحسينيّة؛ لأنّ الخطاب السابق أكّد أنّ البذل النفسي لا يؤتي ثماره المطلوبة حتى يكون في الحسين×، لا في غيره من القيم والمبادئ مهما كانت سامية وعالية، ولذلك قال (فينا) وهنا قال (بي)، فشرط اللحاق أن يكون (بي) لا بغيري، ليكون الاستشهاد المطلوب عن عقيدة في النهضة الحسينية لا في غيرها من النهضات التي تلتها ولم يكتب لها النجاح.
6ـ الاستشهاد ـالذي هو جواب الشرطـمتوقّف على اللّحاق بالركب الحسيني، الذي هو فعل الشرط، ولا شكّ أنّ الجملة الشرطية هي القضية الشرطية المتّصلة في الاصطلاح المنطقي، والتي تعني أن يكون بين المقدّم والتالي اتصال، فيكون التالي (الشهادة) متوقّفاً على حصول المقدَّم (اللحوق) وجوداً وبقاءً. وفيما نحن فيه تكون الشهادة حاصلة بلحاق الركب الحسيني، وبقاء المُلتحق حتى النهاية ثابتاً على النهج، هذا إن كان الخطاب الحسيني على نحو القضية الخارجية[463]، أي: كون الخطاب يتضمّن من أرسل إليهم الكتاب فقط. بيد أنّ المزاوجة بين هذا الخطاب وبقيّة الخطابات العامّة التي تطلق مفهوم الاستنصار على علّاته من غير تقييد بجماعةٍ دون غيرها، ولا بزمان معيّن، تقضي بأن يكون هذا الخطاب الآنف على نحو القضية الحقيقية، أي: شموله لكل من يسمع به ولو أتى بعد حين. ولعلّ في قول الرسول’: «إنّ الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة»[464]، دلالة على أنّ اللحاق بسفينته المقدّسة ما زال سارياً إلى يومنا هذا، ما يعني أنّ نصرة الحسين×لا تخضع للمحددات الزمكانية.
قال الحسين× في الكتاب ذاته: «ومن لم يلحق بي لم يُدرك الفتح»، وهي قضيّة شرطيّة أيضاً، مؤلّفة من المقدَّم هو فعل الشرط السلبي (عدم اللّحاق)، وجواب الشرط السلبي (عدم إدراك الفتح)، فما هو الفتح الذي قصده الإمام×؟ لفظ الفتح مبهم قد يلتبس على سامعه؛ لصدقه على معان عدّة، منها:
أ ـ إزالة الإغلاق والإشكال، وذلك ضربان:
أحدهما: يُدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه من فتحٍ للقفل والغلق والمتاع، نحو قوله: (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ)[465]، (وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ)[466].
الثاني: يُدرك بالبصيرة كفتح الهمّ؛ وهو إزالة الغمّ، وفيه معانٍ عدّة، منها: ما جاء في الأمور الدّنيويّة كغمّ يُفرّج، وفقر يُزال بإعطاء المال ونحوه، كقوله تعالى: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ)[467] أي: وسعنا[468]. وقال تعالى: (فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ)[469]، أي: أقبل عليهم الخيرات[470].
ب ـ فتح المُستغلق من العلوم، كقولك: فلان فَتَحَ من العلم باباً مغلقاً، وقوله تعالى: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا) قيل: عنى فتح مكَّة، وهو قول عائشة زوج رسول الله’[471]، وقيل: بل عنى ما فُتح على النّبيّ’ من العلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثّواب، والمقامات المحمودة التي صارت سبباً لغفران ذنوبه[472]. وفَاتِحَةُ كلّ شيء مبدؤه الذي يفتح به ما بعده، وبه سُمّي فاتحة الكتاب، وقيل: افْتَتَحَ فلان كذا: إذا ابتدأ به، وفَتَحَ عليه كذا: إذا أعلمه ووقّفه عليه. وقوله: (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)[473]، وقوله تعالى: (قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ)[474]، أي: يوم الحكم، وقيل: يوم إزالة الشّبهة بإقامة القيامة، وقيل: ما كانوا يَسْتَفْتِحُونَ من العذاب ويطلبونه، والِاسْتِفْتَاحُ: طلب الفتح[475].
وبناءً على ما مرّ؛ يُستلزم مقاصد عدّة قد تضمّنها الخطاب الحسيني الذي يمكن تحليله من عدّة أوجه:
1ـ كي لا يظنّ ظانٌّ أنّ المقطع الأوّل من الخطاب الذي هو التركيب أو المنطوق في قوله: (من لحق بي استشهد)، يتضمّن مفهوماً سلبياً كما يقول الأصوليون ضمن مباحث الجملة الشرطية؛ أي: أنّ عدم اللحاق يُفضي إلى عدم الاستشهاد، لذلك قطع النصّ الظنّ على الدارسين بعدما بيّن بأنّ عدم اللحاق يعني عدم إدراك الفتح، وليس عدم الشهادة.
2ـ يكشف الخطاب الذي يؤكّد عدم إدراك الفتح بأنّ الإمام×قد ضمّن قوله هذا ذمّاً مُستَبطناً؛ لأنّ عدم إدراك الفتح يعني فواته عن الطلب، فيفهم أنّ فوات الفتح يوجب بعد المسافة بينهما، والمقتضية لسلب النعمة الإلهية من تاركي اللحاق بالحسين×. وهذا الكلام ليس وقفاً على مبغضي الحسين×، بل يشمل الذين يحبّونه ويوالونه، لكنّهم لم يحضروا معه في كربلاء، فحُرموا الحصول على مقام الفتح الحسيني، باستثناء من بقي بإجازة وترخيص من الإمام×[476].
3ـ لم يكن مراد الخطاب إجراء مقابلة لغوية بين الاستشهاد والفتح بوصفهما لفظين متقابلين أو متضادّين، بعبارة أخرى: ما يحكيه الخطاب هو أنّ الالتحاق مع الحسين×في كربلاء يعني الشهادة لا محالة، ولكن لا يعني أنّ عدم الشهادة في معسكر الحسين×مُستلزم لعدم الفتح. فالإمام×لم يقصد من استلزام الفتح المعنى المطابقي للمفهوم، وهو دلالة الفتح على معنى الشهادة ليس إلّا، بل قصد الدلالة الضمنية للفتح في الانطباق على معنى الشهادة، أي: أنّ الشهادة في كربلاء هي بعض الفتح الحسيني، وليست جميع الفتح، إن لم نقل أنّها وقفٌ على الملتحقين من الرجال دون سواهم من أشخاص الركب، بدليل أنّ الإمام علي بن الحسين×كان من معسكر الحسين×، ولكنّه لم يستشهد في كربلاء، وبقي حيّاً بعد الواقعة مدّة طويلة من الزمن، وهذا البقاء لا يخرجه عن دائرة الحاصلين أو المدركين لمقام الفتح الحسيني ـكما تبيّن في مضمون المراد من الفتح ودلالتهـ. إذًا يتعيّن أن يكون الفرد حاضراً في كربلاء كي يكون مشمولاً بهذا المقام، وأن يكون مع معسكر الحسين×، لا مع أعدائه.
4ـ ثمّة مشابهة بين الفتح الحسيني وبين الفتح المحمدي المشار إليه بقولهI: (إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا)[477]، فقد جاء في سبب نزول الآية الشريفة أنّ الفتح المبين هو صلح الحديبية[478]، الذي عدّه اللهI فتحاً للمسلمين، مع أنّ الصلح اشترط على المسلمين عدم دخول مكّة لأداءِ العمرة، وأن يعودوا في السنّة القادمة على أن تكون السيوف في أغمادها، وغيرها من الشروط التي أملتها قريش على الرسول’[479]، ومع كل ذلك يبشّر الرسول’ بأنّ ذلك هو الفتح المبين. ومردّ ذلك إلى النتائج المستقبلية الهامة التي ستنبثق عن هذا الفتح، والتي ستصبّ في مصلحة الإسلام المسلمين «فإنّ الله منح نبيّه الكريم في ظل هذا الفتح المبين أربع مواهب عظيمة، هي (المغفرة) و(إتمام النعمة) و(الهداية) و(النصر)»[480].
وهذا الفتح يتناسب مع الفتح الذي أعطاه للحسين×، فأمّا المغفرة فهي المنزلة الرفيعة في الجنّة، والتي وعده بها جدّه النبي الأكرم’ حين إقدامه على الشهادة، والنعمة هي نعمة الشهادة والشفاعة والرجوع إلى الله تعالىI من خلال سفينة الحسين×، فقد كان الحسين×هادياً مهديّاً وناصراً ومنتصراً. ولعلّ الباحث لا يُجانب الواقع إن رأى بأنّ هذه المعاني يختزلها جواب الإمام زين العابدين×لمن سأله بعدما عاد من كربلاء: من الغالب أو المنتصر في واقعة عاشوراء؟ فقال له الإمام علي بن الحسين×: «إذا أردت أن تعلم من غلب ودخل وقت الصلاة، فأذِّن وأقم»[481]. فالإمام×قصد إيضاح المعيار الحقيقي للفوز أو الخسارة، ولا يمكن تقييمهما بما يحصل في ساحة المعركة، بل هو ببقاء القيم والمبادئ ـ التي من أجلها كانت ثورة الإمام× ـ وعدمه[482].
تلبس بعض الخطابات لباس الغموض يعزوه الإستغراق في استعمال الأساليب البلاغية، من قبيل الخطاب المستعمل في علم الكلام، حيث يعدّ الغموض عند أهل البلاغة من مظاهر البديع، وأحد المحسّنات البديعية.
يبرز ذلك حين تبنّى الخطيب البليغ لفكرة أو رأي، ومن ثمّ يأتي على صحّة رأيه ودعواه بإبطال دعوى خصمه عبر حجّة عقليّة برهانية استدلالية. وقد نسبت هذه التسمية للجاحظ؛ لأنّ الخطيب أو المتكلّم إذا أطلق الحجج العقلية في كلامه، يكون قد سلك مذهب علماء الكلام[483]، وسُمّي علم الكلام بأعظم مسألة فيه؛ ألا وهي "مسألة كلام الله"[484].
مثال ذلك ما جاء في قول الإمام الحسين× غداة اليوم الذي استشهد فيه: «يا عباد الله، اتّقوا الله، وكونوا من الدنيا على حذر؛ فإنّ الدنيا لو بقيت لأحد أو بقي عليها أحد، لكانت الأنبياء أحقّ بالبقاء، وأولى بالرّضاء، وأرضى بالقضاء؛ غير أنّ الله تعالى خلق الدنيا للفناء، فجديدها بال، ونعيمها مضمحلّ، وسرورها مكفهرّ، المنزل تلعة، والدار قلعة؛ فتزَوَّدُوا فإِنَّ خَيْر الزادِ التَّقْوى، واتّقوا الله لعلّكم تفلحون»[485].
ونظيره ما جاء في خطبة التحذير من الدنيا للإمام علي بن الحسين×، بدأ فيها بحمد الله، وأثنى عليه، وذكر جدّه فصلّى عليه، ثُمَّ قال: «أيّها النّاس، أُحذّركم من الدنيا وما فيها، فإنّها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال، وهي قد أفنت القرون الماضية والأُمم الماضية، وهم الّذين كانوا أكثر منكم مالاً، وأطول أعماراً، وأكثر آثاراً، أفنتهم أيدي الزمان، واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنّهم لا كانوا لها أهلاً ولا سكّاناً، وقد أكل التراب لحومهم، وأزال محاسنهم، وبدّد أوصالهم وشمائلهم، وغيّر ألوانهم، وطحنتهم أيدي الزمان، أفتطمعون بعدهم بالبقاء، هيهات هيهات، فلابدّ من اللحوق والملتقى، فتداركوا ما مضى من عمركم وما بقي، وافعلوا فيه ما سوف يعدّ لكم من الأعمال الصالحة قبل انقضاء الأجل، وفروغ الأمل، فعن قريب تؤخذون من القصور إلى القبور، حزينين غير مسرورين، فكم ـواللهـمن فاجر قد استكملت عليه الحسرات، وكم من عزيز وقع في مسالك الهلكات، حيث لا ينفعه الندم ولا يغاث من ظلم، وقد وجدوا ما أسلفوا، واحذروا ما تزوّدوا، ووجدوا ما عملوا حاضراً، ولا يظلم ربّك أحداً، فهم في منازل البلوى همود (مسرعين)[486]، وفي عسكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة، وحلول يوم الطامّة(لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا)، (وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى)»[487].
ففي قول الإمام الحسين׫فإنّ الدنيا لو بقيت على أحد... لكانت الأنبياءُ أحقّ بالبقاء» حجّة عقلية مما يحتجّ به علماء الكلام، وصيغة الدليل تسمّى عند أهل المنطق بالقياس الإستثنائي المستخدم عادة في القضية الشرطيّة المتصلة[488]:
(المقدّم) (التالي)
ـ لو بقيت الدنيا على أحد
لبقت على الأنبياء
ـ لكنّها لم تبق على الأنبياء
(النتيجة)
فالدنيا لن تبقي على أحد
تبنّى الإمام×في معرض كلامه الذي استلزم التحذير من الدنيا بعد أن أثنى على الله وأمرهم بتقوى الله، دعوى مفادها أنّ الدنيا ليست باقية لأحد، أو باق عليها أحد. وساق دليلاً لإثبات دعواه بقوله: (لكانت الأنبياء أحقّ بالبقاء...). وهذا دليل جازم على فناء الدنيا وعدم بقائها، فهي لم تبق لخاصّة البشرية والصالحين من الخلق، فكيف تبقى لمن دونهم في الرتبة؟! إذاً فكل شيء زائل إلّا وجه الله. وما رشح هذا القصد، قوله الذي أردفه لتقوية وتأكيد متبنّاه: «غير أنّ الله خلق الدنيا للفناء...»، وهذا القول يشاكل ما قبله. إذ من حق الإمام×الإكتفاءعلى وفق قاعدة الطريقة التي تقتضي الوضوح والإيجاز بقوله «اتقوا الله واحذروا من الدنيا فهي زائلة»، ولكن الخرق حصل حين أخذ الإمام×بالإطناب بعد أن عمد إلى استخدام هذا المحسّن البديعي، مضيفاً عليه محسّناً آخراً بقوله: «فجديدها بال، ونعيمها مضمحلّ، وسرورها مكفهرّ، المنزل تلعة والدار قلعة»، وهو ضرب من ضروب الإطناب يسمّى بالاستقصاء؛ يقتضي أن يتناول الخطيب بيان معنىً، فيستقصيه من كل جوانبه، آتياً بجميع لوازمه وعوارضه، بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية، حتى يقطع الطريق أمام من يتناوله بعده بإضافة مقالٍ فيه[489]. ومثيل هذا الاستقصاء أو الاستقراء يجده القارئ في خطاب الإمام السجاد×الآنف الذكر، حيث استلزم الخرق في كلا الخطابين الإطناب لبلوغ قصد الإمامين÷ في التنفير من الدنيا، وترك كل ما فيها، وهو ما يفيد في تقوية القصد الرئيس من خطابهما وهو تقوى الله والتحذير من الدنيا وخداعها.
إنّ الإمام السجاد×أخذيستقصي كل عوارض الدنيا ولوازمها؛ فقال:
ـ تفني القرون الماضية، وتفني الأمم الماضية.
ثم عمد إلى ذكر أحوال تلك الأمم:
ـ فهم أكثر منكم مالاً، وأطول أعماراً، وأكثر آثاراً.
ومع كل هذا ماذا فعلت بهم الدنيا؟
ـ أفنتهم يد الزمان، واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، وأفنتهم الدنيا فكأنّهم لا كانوا لها أهلاً ولا سكّاناً، قد أكل التراب لحومهم، وأزال محاسنهم، وبدّد أوصالهم وشمائلهم، وغيّر ألوانهم، وطحنتهم أيدي الزمان.
في هذا الخطاب نجد أنّ الإمام×بعد استعراضه لكل لوازم الدنيا وعوارضها، أخذ يوضّح صفات الأمم السابقة التي امتازت بكثرة الأموال، وطول الأعمار، وكثرة الآثار. ثمّ عاد مرّة أخرى ليكرّر مفردة الفناء، لكنّه لم يكرّرها مجرّدة، بل جسّمها بهيئة بشر، فاستعار لها جارحة من جوارح الإنسان وهي اليد بقوله «أفنتهم يد الزمان» و«طحنتهم أيدي الزمان»؛ كل ذلك من أجل تقريب صورة الدنيا الفانية والمُفنية لأهلها إلى أذهان النّاس. وهذا التكرار للمفردة الذي بلغ ثلاث مرّات والرابعة كرّرها بالمعنى، خرج بقصد تعدّد المقتضي[490] وهو القصد الرئيس للخطاب «التحذير من الدنيا وتنقلاتها» مع ذكر أسباب التحذير.
إنّ الاقتصار على لفظ (الدنيا فانية) كان كافياً في التحذير من الدنيا، إلّا أنّه×خرق القاعدة، وراح يفسّر أحوال الدنيا وتقلّباتها وما فعلته وستفعله بهم، مستعيناً بأروع وأدقّ أدوات التصوير البلاغية، وهي الاستعارة، فهي تحتلّ مرتبة أعلى من التشبيه؛ لأنّها أكثر منه توغّلاً في أساليب البيان غير المباشر[491]، فكشف بذلك بيان أحوال الدنيا؛ ليبيّن لهم انكاره وتقبيحه الشديدين للطمع فيها، وهذا ما أنجزه الفعل اللّغوي المباشر في قول الإمام «أفتطمعون بعدهم بالبقاء»، والذي دلّت عليه صيغة الاستفهام الذي أنجز بفعل المقام وسياق الحال فعلاً لغوياً غير مباشر، استلزم قصدين:
الأوّل: إيهام المتلقّي (أهل الشام) وغيرهم أنّه×يعلم أنّ الطمع حاصل منهم لا محالة، هذا إذا كان يريد من الفعل المضارع الحال «فإذا قلت: أتفعل؟ كان المعنى على أنّك أردت أن تقرّره بفعل هو يفعله، وكنت كمن يوهم أنّه يعلم بالحقيقة أنّ الفعل كائن»[492].
الثاني: قصد توجيه إنكار الطمع وتقبيح حصوله لكل من يسمع خطابه حاضراً أومستقبلاً، ويرى الجرجاني «وإن أردت بـ تفعل المستقبل كان المعنى: إذا بدأت بالفعل على أنّك تعمدُ بالإنكار إلى الفعل نفسه، وتزعم أنّه لا يكون أو أنّه لا ينبغي أن يكون»[493]، إذاً فالإمام×يستقبح حصول الطمع ـ في وقت إرسال الخطاب وفي المستقبل ـ من المتلقّي، بل وينهاه عن توخّي مثله.
كما يمكن أن يُلتمس بوضوح منهج أهل البيت^ في تضمين خطبهم آيات الذكر الحكيم؛ بوصفها المعين الأوّل للهداية، ولهذا ختما خطابيهما بالتذكير من آيات القرآن المجيد، فقد ضمّن الإمام الحسين× خاتمة خطابه بقوله: (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا)(وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى) إشارة إلى قوله تعالى: (لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ)[494]، وقوله أيضاً: (وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى)[495] فالإمام× ألمح إلى هاتين الآيتين بقصد الدعاء. فجاء دعاؤه للمؤمنين مرتين متمثلا في طلب مجازاتهم بالمغفرة والرزق الكريم، وللمحسنين بالحسنى، أمّا للمسيئين فجاء دعاؤه مرّة واحدة؛ حتى يكون الجزاء بمثل ما عملوا فقط. فيكون بذلك قد أكّد أمراً أشار إليه القرآن، وهو أنّ جزاء المؤمنين أضعاف جزاء المحسنين؛ أي: أنّ عملهم نتيجة الاعتقاد الراسخ فالجزاء مضاعف، في حين المحسن قد يكون مؤمناً وقد يكون غير ذلك، وعلى فرض أنّه غير مؤمن فسيجازى بإحسانه. وهذا لطف الله ورحمته في عباده، وليس غريباً هذا الخُلق عن أهل بيت الرحمة الذين تربّوا في حجر وكنف الرسول محمد’ الذي مدحه القرآن بقوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)[496].
في حين تجد الإمام× في نهاية خطابه ضمّنه آيتين: الأولى أشارت إلى قوله تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)[497]. والثانية قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)[498]أو قوله أيضاً: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[499]. ولا شكّ أنّ الإمام× حينما ضمّن خطابه المبارك ـوهو في سياق توجيه النّاس لتقوى الله، وتحذيرهم من الدنيا الزائلةـقصد الإلماح والإيماء إلى قصد خفي وغامض لا يدرك إلّا بإعمال الفكر وكدّ الذهن، ولعلّه أراد بذلك:
1ـ لمّا ثبت أنّكم مأمورون بمخافة الله «اتقوا الله لعلّكم تفلحون، يعني واتقوا ما نهاكم الله عنه، وزهّدكم فيه، لكي تفلحوا بالوصول إلى ثوابه الذي ضمنه للمتّقين»[500] وأنّ الدنيا زائلة فتزوّدوا، فإنّ ما تفعلونه من خير يعلمه الله، ومن مصاديق الخير المودّة في القربى، فخافوا الله أيّها العقلاء بعدم سفك دم العترة الطاهرة، حيث يقوّي هذا الفهم، القصد الثاني.
2ـ قصد الإمام× الربط بين تأويل الآيتين بأكثر من معنى:
أ ـ قصد الإمام الإشارة إلى حديث النبي’ «أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها ». بقوله تعالى (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا) قال القمّي في تفسيره: «قال: نزلت في أمير المؤمنين× لقول رسول’: أنا مدينة العلم وعلي× بابها، ولا تدخلوا المدينة إلّا من بابها»[501].
ب ـ ورد في تفسير آية "البرّ" المذكورة في قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[502]، عن سعد[503]، عن أبي جعفر×، قال: سألته عن هذه الآية (وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)فقال: «آل محمد’ أبواب الله وسبيله، والدعاة إلى الجنّة والقادة إليها والأدلاء عليها إلى يوم القيامة»[504]، وثمّة ربط لطيف، وتنويه عال المضمون بحاجة إلى تروٍّ من القارئ اللبيب، ألا وهو علاقة التقوى بإتيان الأبواب، وعلاقتهما بالبِرّ، فالبرّ: خلاف العقوق، وفلان يبرّ خالقه ويتبرّره، أي: يطيعه[505]، والبرّ: الصدق والطاعة[506]، والتقوى من توق، والتوق: نزاع النفس إلى الشيء، تتوق إليه توقاً، وتاقت نفسي إليه، ونفس توّاقة: مشتاقة[507]. وبعدما تبيّن لنا معنى التقوى والبرّ لسائل أن يسأل: ما الفرق بينهما؟ قال الطباطبائي «كان الظاهر أن يقال: ولكن البرّ هو التقوى، وإنّما عدل إلى قوله: ولكنّ البرّ من اتقى، إشعاراً بأنّ الكمال إنّما هو في الاتصاف بالتقوى وهو المقصود، دون المفهوم الخالي، كما مرّ نظيره في قوله تعالى: (ليس البرّ أن تولّوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكنّ البرّ من آمن) الآية»[508]. أما إذا أردنا بالأهلّة غير ذلك المعنى الرمزي الذي تعطيه مفردة أهلّة، وهو أنّ عدّتها اثناعشر شهراً، فهذا يستلزم إيماءً إلى عدد الأئمة الاثني عشر.
وكيفما كان؛ فجملة (ليس البرّ) من شأنها أن تُشير إلى نكتة لطيفة أخرى ـ أيضاً ـ وهي أنّ سؤالكم عن الأهلّة بدل سؤالكم عن المعارف الدينية بمنزلة من يترك الدخول إلى داره من الباب الأصلي، فيرد من ظهر البيت، وهو عمل مستقبح ومستهجن، لذا يجب الالتفات ضمناً إلى هذه النكتة في قوله تعالى: (لكنّ البرّ من اتقى) أنّ وجود المتّقين بمثابة الينابيع المستفيضة بالخيرات، إذ أنّهم قد يطلق عليهم كلمة (البرّ) نفسه[509].
تخرق قاعدة الطريقة أو الجهة[510] ـ التي تحثّ على التزام الإيجاز والوضوح ـ في إطالة الكلام والمبالغة بملفوظات كثيرة[511]، والإطناب هو أداء المقصود من الكلام بأكثر من عباراته، سواء كانت القلّة أو الكثرة راجعة إلى الجمل أم إلى غير الجمل[512].
ومن ذلك قول الإمام السجاد× في مجلس يزيد بالشام: «أيّها النّاس، أعطينا ستاً، وفضّلنا بسبع: أُعطينا العلم، والحلم، والسماحة، والفصاحة، والشّجاعة، والمحبّة في قلوب المؤمنين. وفضّلنا بأنّ منّا النبيّ المختار محمداً’، ومنّا الصّديق، ومنّا الطيار، ومنّا أسد الله وأسد الرسول، ومنّا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنّا سبطا هذه الأمّة، وسيّدا شباب أهل الجنة، فمن عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي: أنا ابن مكّة ومنى، أنا ابن زمزم والصّفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردا، أنا ابن خير من ائتزر وارتدى، أنا ابن خير من انتعل واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حجّ ولبّى، أنا ابن من حُمل على البراق في الهوا، أنا ابن من أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسبحان من أسرى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنى فتدلّى فكان من ربّه قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلّى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمّد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا: لا إله إلّا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وصلّى القبلتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين، ووارث النبيين، وقامع الملحدين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتاج البكّائين، وأصبر الصّابرين، وأفضل القائمين من آل ياسين، ورسول ربّ العالمين، أنا ابن المؤيّد بجبرائيل، المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخر من مشى من قريش أجمعين، وأوّل من أجاب واستجاب لله من المؤمنين، وأقدم السّابقين، وقاصم المعتدين، ومبير المشركين، وسهم من مرامي الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، ناصر دين الله، وولي أمر الله، وبستان حكمة الله، وعيبة علم الله، سمحٌ سخيٌ، بُهلول زكي أبطحي رضي مرضي، مقدام همام، صابر صوّام، مهذّب قوّام، شجاع قمقام، قاطع الأصلاب، ومفرّق الأحزاب، أربطهم جناناً، وأطلقهم عناناً، وأجراهم لساناً، وأمضاهم عزيمة، وأشدّهم شكيمة، أسد باسل، وغيث هاطل، يطحنهم في الحروب ـ إذا ازدلفت الأسنّة، وقربت الأعنّة ـ طحن الرحى، ويذروهم ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز، صاحب الإعجاز، وكبش العراق، الإمام بالنصّ والاستحقاق، مكّي مدني، أبطحي تهامي، خيفي عقبي، بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيّدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين، وأبو السبطين، الحسن والحسين، مظهر العجائب، ومفرّق الكتائب، والشهاب الثاقب، والنور العاقب، أسد الله الغالب، مطلوب كل طالب، غالب كل غالب، ذاك جدّي علي بن أبي طالب، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيّدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول، أنا ابن الحسين القتيل بكربلاء، أنا ابن المرمّل بالدماء، أنا ابن من بكى عليه الجن في الظلماء، أنا ابن من ناحت عليه الطيور في الهوا»[513].
يظهر في هذا النصّ الإطناب جليّاً من أداء المعاني بألفاظ كثيرة، ومقتضى القاعدة أن يجري الخطاب على وفق تحرّي الإيجاز، كأن يقول «أنا ابن محمّد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى... أنا ابن الحسين القتيل بكربلاء...»ولما بالغ الخطيب×في إرسال الكلام على غير الصورة المفترضة في الأصل، أدّى إلى حصول الخرق للكيفية، وفي هذا النصّ يرى القارئ أنّ الإطناب في إرسال الخطاب استلزم من النكت البلاغية الجميلة ما يفوق الحصر، فهناك خمس عشرة طريقة من طرائق أداء الإطناب والتطويل، وكل طريقة لها نكتة بلاغية لطيفة ومقصد تواصلي ألطف[514]، وأوّل ما يطالع البحث من طرق التطويل والإطناب:
الطريقة الأولى: الإيضاح بعد الإبهام، ومنها التفصيل بعد الإجمال[515]، من قبيل قول الإمام «أُعطينا ستاً وفضّلنا بسبع» ثم أطنب وقال «أعطينا العلم، والحلم، والسخاء، والفصاحة، وفضّلنا بأنَّ منّا النبي المختار، ومنّا الصديق...». وهنا أوضح الإبهام وفصّله بعد الإجمال كما في قوله تعالى (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)[516]. أضف إلى ذلك أنّ الخرق استلزم من المقاصد التي أراد الخطيب إيصالها إلى من حضر في مجلس يزيد خاصّة، وأهل الشام عامّة؛ ما يلي:
1ـ بدّل نشوة الانتصار لدى السلطة إلى حشرجة الموتى في حلوق المحتفلين، عن طريق تقديم المعنى الواحد في أسلوبين مختلفين، هما: الإبهام والإيضاح[517].
2ـ تمكين المعنى الذي قصده في نفوس الحاضرين تمكيناً زائداً[518]، لوقوعه بعد استشراف النفس إليه بالإبهام، وهو ما فنّد كل الدعايات المضلّلة التي روّجتها السياسة الأموية، والتي تركّزت على: أنّ الأسرى هم من الخوارج، فلم يعرف أهل الشام لا مصداق المختار ولا الصدّيق ولا الطيّار، ولا أسد الله وأسد الرسول[519]، ولا سبطي هذه الأمّة، ولا البتول...، كل هذه المعاني كانت غائبة، ومغيّبة من قبل السلطة الغاشمة عن قصد وتعمّد.
3ـ تكميل الإمام× لذّة العلم بحال الأسارى ـ الذين اتُهموا بالخوارج ـ إذ بدت ناقصة بالإبهام وكملت بالإيضاح، فالشيء إذا عُلم ناقصاً تشوّفت النفس إلى العلم به كاملاً، وحصل لديها ظمأ لمعرفته[520]، ولعلّ هذا القصد من أبرز مسوّغات القصد التي توخّاها الإمام× في إطنابه، فأخذ يفسّر ويطوّل بالإيضاح، فقد ذكر السماحة والسخاء، وأخذ يكرّرها بقوله: (سمح، سخي، زكي، أبطحي، رضي مرضي)، وذكر الشجاعة وكرّرها باللفظ وبلوازمها مرّة أخرى بقوله: «مقدام همام، صابر صوّام، مهذّب قوّام، شجاع قمقام، قاطع الأصلاب، ومفرِّق الأحزاب، أربطهم جناناً، وأطلقهم عناناً، وأجراهم لساناً، وأمضاهم عزيمةً، وأشدّهم شكيمةً».
4ـ ذكّر× ـ أيضاً ـ بكل المواقع الجغرافية، والمواقف الحاسمة، والذكريات العظيمة في الإسلام، وربط نفسه بكل ذلك، فسرد ـ وبلغة شخصيّة ـ حوادث تاريخ الإسلام، معبّراً بذلك عن أنّه يحمل هموم كل ذلك التاريخ على عاتقه، وأنّه حامل هذا العبء، بكلّ ما فيه من قدسيّة، ومع هذا فهو×يقف (أسيراً) أمام السلطة الأموية عبر حسن إطلاقه للاسم الموصول الذي تمكّن من تطويعه لنقل المقاصد أعلاه، فقد وظّفه في التعريف والإشارة لنفسه وارتباطه بكل المواقف والأحداث الزمكانية؛ «فالاسم العلم، هو أقوى المعارف، تليه المبهمات (الاسم الموصول، واسم الإشارة، الضمير) عند أغلب النحاة»[521]، وما يساعد المتكلّم في أن يلجأ إلى هذا التعريف هو مقام التلفّظ، أي عندما يكون نقص في معلومات المخاطب عن المسند إليه، ما خلا الصلة مثل الذين قاتلوا مع الحسين علماء صالحون[522].
5ـ قصد إطلاق الكناية التي هي أبلغ من التصريح، بنسبه الشريف، وباتصاله بالإسلام، وبرسوله الكريم’.
6ـ قصد بيان منزلته العالية المتأتية من اتصاله المادي والمعنوي برسول الله’، وعلي ابن أبي طالب×، ومع ذلك يقف أسيراً بين يدي من هم أقلّ منه شرفاً.
7ـ إظهار الصورة الناصعة لعلي بن أبي طالب×، التي طالما شوّهها بنو أميّة في الشام.
وفي ظل زمكانية الظروف المقامية، لم يكن للإمام السجاد×أن يتطرّق إلى شيء من القضايا الهامّة عبر الفعل الكلامي المباشر، وإلّا كان يُمنع من الكلام والنطق[523]، وأما الإعلان عن اسمه فهي قضية حاكية عن هويّته الشخصية؛ لذا اغتنم الامام×ذلك الحق الذي يمنح لكل فرد حتى وإن كان أسيراً؛ كي يوصل مقاصده للحاضرين بأبلغ صورة حتى تُحسِسَ وقعها من خلال ضجّ من كان في المجلس بالبكاء، مما دفع يزيد أن يقطع استرسال الإمام×بالأذان إلّا أنّه (يزيد) غفل عن أنّ الإمام×أفرغ كل ما في جعبته من مقاصد، ما حدا بالإمام×أن يمتاح من عبارات الأذان وألفاظه حججاً دامغة على يزيد.
2ـ الطريقة الثانية التكرار، مما ينضوي تحت مفهوم الإطناب في سياق الخبر (التكرار) الذي يمكن عدّه تطويلاً في إطلاق القول، يأتي به المتكلّم عندما يقصد المبالغة في الشرح والتوضيح، فيُسرف في التكرار[524]، والتكرار «عبارة عن تكرير كلمة فأكثر باللفظ والمعنى لنكتة»[525]، وهو من الأنماط المهمّة، وسنّة من سنن العرب الحاضرة في كتاب اللهI، من ذلك قوله تعالى: (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)[526].
يستثمر الخطيب التكرار للإبلاغ عن قصده حسب عنايته بالأمر[527]، وقد تعدّدت غاية التكرار وأنواعه في خطب المسيرة، وفي هذا الخطاب أكثر من غاية ونوع سيمرّ بها القارئ في توضيح حالات الإطناب التي من شأنها خرق قاعدة الطريقة، إذ يأتي التكرار في الكلمة، والجمل، والحرف، فعلى سبيل المثال: بلغ تكرار (أنا ابن) أكثر من ثماني عشرة مرّة، وجاء التكرار تارة بالصفة، وتارة بالاسم الصريح، وتارة بالمشتق... الخ. ومن غايات التكرار:
وهو من أشهر الأبواب النحوية عناية عند النحاة القدامى، فعند سيبويه (180هـ) صورة من صور الخروج على مقتضى الظاهر «وضع الظاهر موضع الضمير، لزيادة التمكين والتقوية في النفس»[528]، بل أنّ «التوكيد اللفظي قد يكون لدفع توهّم التجوّز والسهو المعنوي»[529]، ومما يقارب هذا المفهوم خطاب الإمام علي بن الحسين×إلى أهل الكوفة: «هيهات هيهات، أيّها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إليّ كما أتيتم إلى آبائي من قبل»[530].
وكذا خطابه في أهل الشام حذّرهم فيه من الدنيا ومزالقها بقوله: «أفتطمعون بعدهم بالبقاء، هيهات هيهات، فلابدّ من اللحوق والملتقى، فتداركوا ما مضى من عمركم وما بقي». حيث أشارتالدلالة الأساسية في خطاب الإمام×إلى رفضه ونفيه القاطع ببقاء أحد على وجه البسيطة، وهذا المعنى دلّ عليه فعل القول القضوي الذي دلّت عليه القرينة، وهي صيغة اسم الفعل الماضي (هيهات) الذي يأتي بمعنى (بعُدَ)[531]، كما تُستعمل (هيهات) لاستبعاد مظنّة حصول حدث ما[532]؛ لأنّها أقوى من الفعل الذي بمعناها في أداء المعنى وأقدر على إبرازه كاملاً مع المبالغة فيه[533]، فمعناها الدقيق: (بعُدَ جدّاً) ولما تكرّرت أفادت البُعد الشديد بعداً آخر، وفضلاً عما أضافه التكرار من إيقاع صوتي فـ«هي صوت يقوله العربي حين يستبعد شيئاً أو أمراً، وهو تعبير عن انفعاله هذا»[534].
إذاً (هيهات) أفادت معنى الاستبعاد، في حين تجد أنّ الفعل الكلامي الإنجازي الذي نتج من تكرار اسم الفعل أفاد معنى استلزم من تكرار الكلمة والظرف المقامي، فخرج إلى معنى قصده المتكلّم وهو التيئيس؛ لأنَّ هيهات إذا كانت موجّهة لذات المتكلّم فمعناها القضوي يتجاوز معنى الاستبعاد إلى اليأس، أمّا إذا وجّهت لذات المتلقّي، فيكون معناها مع الاستبعاد: التيئيس[535] ومن هنا يمكن صياغة المقاصد في الخطابين أعلاه بشكل أدقّ في:
1ـ خطاب الإمام× لأهل الكوفة الذي رفض فيه عرض أهل الكوفة بالولاء والطاعة على نحو التيئيس وقطع الظنّة.
2ـ تكرار اسم الفعل الذي ناسب مقام إبطال المزاعم وكشف الحقائق.
3ـ خطابه لأهل الشام الذي قطع الطريق أمام طمعهم في الخلود في هذه الدنيا عن طريق تكرار (هيهات) التي أفادت معنى التيئيس على نحو المبالغة والتأكيد، وما رشّح هذا المعنى قوله «فلابدّ من اللحوق والملتقى»، حيث أشار في هذا المقطع إلى أصل مهم من أصول الدين وهو المعاد[536]، ومنها أيضاً خطاب زهير بن القين لأهل الكوفة «يا أهل الكوفة، نذار لكم من عذاب الله نذار إن حقّاً على المسلم نصيحة أخيه»[537].
ذهب القيرواني (456هـ) إلى أنّ من أغراض التكرار التشويق والاستعذاب[538]، ومما يقارب هذا المفهوم خطاب الإمام الحسين×بعد أن نزل بكربلاء وقال لها: «يا أُخيَّةُ، اتّقي الله وتعَزّي بِعَزاء اللهِ، واعْلمي أنَّ أهلَ الأرْضِ يموتونَ، وأنَّ أَهل السَّماء لا يبْقونَ، وأنَّ كُلَّ شيْء هالكٌ إِلّا وجهَ اللهِ الَّذي خلقَ الأرضَ بِقُدْرتهِ، ويبعَثُ الخلقَ فيعودونَ، وهوَ فردٌ وحدَهُ، أبي خيرٌ منّي، وأُمّي خيرٌ منّي، وأخي خيرٌ منّي، وَلي وَلَهُم ولكُلِّ مُسْلِم بِرسول اللهِ أُسْوةٌ. فعزّاها بهذا ونحوه، وقال لها: يا أُخيَّة».
ومنه أيضاً خطاب السيدة زينب‘ ليزيد في مجلسه ـبعد مقتل أخيها الإمام الحسين×ـبقولها: «والله، ما اتقيت غير الله، ولا شكواي إلّا إلى الله»[539]، فقد أفضى هذا التكرار في لفظ الجلالة وفي لفظ يا أخية سابقاً ـفضلاً عن قصد المواساةـإلى الاستعذاب والتلذّذ باللفظين من الإمام×. ومثله تكرار لفظ الجلالة (الله) في معرض تعريف الإمام بنفسه حين قال: «أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين، وأول من استجاب لله من المؤمنين، وأقدم السابقين، وقاصم المعتدين، ومبير المشركين، وسهم من مرامي الله على المنافقين، ولسان حكمة العابدين، ناصر دين الله، وولي أمر الله، وبستان حكمة الله، وعيبة علم الله»؛ مضافاً إلى تكراره جملة (أنا ابن) تسع عشر مرة. إذ يظهر من تكرار لفظ الجلالة في أغلب التراكيب الإضافية من خطابه× ـسوى بعض الفقرات ـ مزيدٌ من العناية والتلذّذ للتلفّظ بها وبسط للخطاب حيث الإصغاء المطلوب[540]، فضلاً عن ما يضفيه تكرار لفظ الجلالة من قيمة فنّية للخطاب، حيث يتجلّى قصده من ذكر اللهI بالآتي:
1ـ يستعذب المتكلّم فيكرّره، ولا يستعيض عنه بضمير، ما يمنح الخطاب قوّة وتأثيراً؛ كون دلالة الاسم الظاهر أقوى من الضمير[541]، وهذا مما لاشكّ فيه، ديدنهم في استعذاب ذكر اللهI وذكر رسوله’. وهو ما يلمسه القارئ في سفره الخالد وزبور آل محمّد الصحيفة السجادية، حيث لا يخلو دعاء من أدعيتها من ذكر لفظ الجلالة وتكراره والصلاة على محمّد وآله في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره[542]، وهذا الفعل الانجازي أيضاً كان ينجز به قصداً، وهو إظهار بيان منزلة أهل البيت^لدى المجتمع والنّاس الذين غفلوا عنها أو تغافلوا، حتى وصل الأمر إلى أن تعتدي السلطة عليهم وتقتلهم، وتسبي نساءهم وأطفالهم، فالتكرار استلزم قصدية التنبيه والتعظيم للمحكي عنه، وهو من أغراض التكرار[543].
2 ـ في تكرار لفظ الجلالة قيمة فنّية أخرى، تظهر في إيقاعه الذي يشدّ المتلقّي ويملأه شوقاً للإنصات لروعة الرنين[544].
3ـ التقديم والتأخير (تغيير الرتبة)
يلجأ المتكلّم إلى خرق نظام ترتيب الكلام على وفق التركيب اللّغوي الذي نصّت عليه المقولة الفرعية الرابعة عن قصد، فيأتي الكلام على غير ما يقتضيه الظاهر ملوّحاً إلى طرفة بلاغية، يمكن الوصول إليها بإعمال الفكر، أو رهف الحس ودقّة الملاحظة وعمق النظرة[545]، لما له من وقع وتأثير في النفس شديدَين[546]. وهذا الخرق تتحوّل فيه البنية من بنية أصليّة إلى بنية فعليّة، ويحصل بفعل السياق المقامي التواصلي، ولا يقع اعتباطاً، وإنّما يستلزم قصداً معيّناً[547]، إذ يمكن بيان الخرق من خلال سياق الملفوظات في ضمن أسلوب التقديم والتأخير أو تغيير الرتبة.
إنّ الكلمة في نظام اللغة العربية تتمتّع بمقدار كبير من حرّية الحركة داخل التركيب، والتقديم والتأخير أحد أساليب حرّيتها، وخصيصة من خصائصها[548]، وهو «جعل اللفظ في رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها، لعارض اختصاص أو أهمّية أو ضرورة»[549]؛ إذ أنّ ترتيب المعاني والدلالات يقتضي تقديماً وتأخيراً بعضها على بعض بحسب السياق المقامي، لذا هو أسلوب يوضّح ويكشف تفاعل المتكلّمين وانفعالهم وما يشغل بالهم؛ فهم «إنّما يقدّمون الذي ببيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعاً يهمانهم ويعنيانهم»[550] بغية تحقيق الغاية التداولية للخطاب في الإفهام وإيصال القصد إلى المتلقّي بطريقة بيّنة وسهلة، وقد يسعى المتكلّم إلى تقديم بعض أجزاء على بعض فيستلزم العدول والانزياح عن ذلك التسلسل[551]، وعلى هذا الانزياح الذي يتخللها «أن يكون هادفاً إلى دلالة غير ما يؤدّيه التركيب في التسلسل المعياري لرتب أجزائه، وإذ ذلك يكون هذا العدول مفيداً في تغيير الدلالة إلى أخرى...» ويطلق عليه تداولياً مبدأ الإبراز التداولي[552]، وفيما يلي صور من ذلك التقديم أو التأخير.
1ـ تقديم الخبر على المبتدأ: ومما يقارب هذه الخرق في متواليات النظم قول الإمام الحسين×في أكثر من مناسبة:
أ ـ حين نصب يزيد نفسه ملكاً على المسلمين، وطلب من عامله الوليد أخذ البيعة من الإمام، فقال×: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام؛ إذ قد بليت الأمّة براعٍ مثل يزيد»[553]؛ لأنّ التصدّي لخلافة وإدارة شؤون المسلمين أمر مرتبط بالإسلام، وهذا استلزم تقديم المتعلّق بالخبر (الإسلام) على المبتدأ (السلام) قصد العناية والاهتمام بتعاليم الإسلام التي ستنتهك بتنصيب يزيد وببيعته.
ب ـ في خطاب الاستنهاض للمسيرة حين قال×: «رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، ويوفّنا أجور الصابرين». وقبل استجلاء مقاصد الإمام×، يجدر بنا تحديد أمرين مهمّين، قد عرض لهما السيّد الصدر بالتفصيل[554]، هما:
الأمر الأوّل: معنى الرضا؟ والذي ينطوي بدوره على معنيين:
أحدهما: المراد بالرضا بصفته عاطفة نفسيّة محبوبة.
والثانية: هي الأمر المرضي الذي يتعلّق به الرضا عرفاً ولو مجازاً.
الأمر الثاني: هل هذه الجملة حافظت على ترتيبها الأصلي (مبتدأ + خبر) أم حدث فيها خرقٌ وعدولٌ عن ذلك الترتيب؛ أي: (خبر مقدّم + مبتدأ مؤخّر)، وبالتالي ـ مع أخذ الرضا بمعنى (الأمر المرضي)ـتكون الجملة على احتمالين:
ـ على ترتيبها الأصلي، أي: ليس فيها خرق، يكون رضا الله هو المبتدأ، والمعنى القضوي: الدلالة الحرفية لعناصر التركيب، هو أنّ الأمر الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى نرضاه نحن أهل البيت. وهذا هو الفهم الظاهر، فهو يعبّر عن رضاه بمقتله واستشهاده؛ لأنّه أمر مرضي لله سبحانه وتعالى.
ـ على غير الترتيب الأصلي، أي: فيها خرق في سياق الملفوظات، فيكون رضا الله خبرا مقدّماً ورضانا أهل البيت مبتدأ مؤخّراً، فيكون قصده أنّ الأمر الذي نرضاه نحن أهل البيت يرضاه الله} فهو مرضي لله بدوره. وعلى هذا الرأي استلزم تقديم الخبر المقدّم (رضا الله) على المبتدأ المؤخّر (رضانا أهل البيت) قصْدَ الإمام بمزيد العناية والاهتمام برضا الله، فما يرضاه سبحانه وتعالى يرضونه، وهذه منزلة عظيمة. أما إذا كان معنى الرضا معناه المطابقي، وهو الأمر المحبّب للنفس والشعور بالارتياح، فحينئذٍ ليس هناك خرق في سياق الملفوظات.
3ـ حين أذن الإمام× لأصحابه ليلة العاشر من محرّم، قال لهم: «ألا وأنّى قد أذنت لكم فانطلقوا، أنتم في حلّ ليس عليكم منّى ذمام»[555]، حيث أفاد هذا الخرق في سياق الملفوظاتاختصاص أصحابه في نفي الذمام عنهم، وإثباته لغيرهم ممن سمع واعيته ولم ينصره، ولو أخّر الخبر، فقال: ليس ذمامٌ عليكم، لتغيّر معنى الخطاب، ويكون الذمام ليس على أصحابه، كما يحتمل أن ليس على غيرهم، وهذا يتعارض مع تصريحه: «من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبّه الله في نار جهنّم»[556].
وإلى مثل هذا القصد خرج قول الإمام الحسين×حين طالبه الرسول بجواب على كتاب عبيد الله بن زياد، فقال×: «ما له عندي جواب؛ لأنّه حقّت عليه كلمة العذاب» وهنا تقديم الخبر (له) يكشف عن اهتمام الإمام بعدم جواب هذا الكافر، فهو غير مستحق لجوابه، فقد حقّت عليه كلمة العذاب، وكلمة العذاب لا تحقّ إلّا على الكافر، وليست تشهد الجوارح على مؤمن، إنّما تشهد على من حقّت عليه كلمة العذاب، فأمّا المؤمن فيُعطى كتابه بيمينه[557]. فعبيد الله حين تجرّأ على الإمام بكتابه الذي رماه بين يده استلزم منه الكفر وخروجه عن دائرة الإسلام، بدلالة القرينة الحالية، وهي رمي الكتاب، كما استلزم ـ أيضاً ـ أنّ جواب الإمام ×لا ينفعه بأيّة حال من الأحوال بوصفه «من حقّت عليه كلمة العذاب، ولم يخف العقاب، ولا يرجو لله وقاراً، ولم يخف له حذاراً، فشأنك وما أنت عليه من الضلالة والحيرة والجهالة، تجد الله في ذلك بالمرصاد من دنياك المنقطعة، وتمنّيك الأباطيل، وقد علمت ما قال النبي’ فيك وفي أمّك وأبيك، والسلام»[558].
2 ـ تغيير رتبة الفاعل: مما يقارب الخرق في سياق الملفوظات تغيير رتبة الفاعل على الفعل، وهو خرق وعدول عن أصل التركيب، ففي قول الإمام الحسين×يوم العاشر ـبعد أن استشهد جميع أصحابه وأهل بيتهـمنادياً: «هل مِن ذابّ يذُبُّ عن حُرَمِ رسول اللهِ؟ هل مِن موحِّد يَخاف الله فينا؟ هل مِن مُغيث يرجُو الله في إِغاثتِنا، هل مِن مُعين يرجُو ما عندَ اللهِ في إِعانَتِنا؟»[559] ورد تقديم الفاعل على الفعل في سياق الاستفهام، وقد ذهب أغلب النحويين ـ باستثناء المبرّد[560] ـ إلى زيادة (من) إذا سبقها استفهام أو نفي أو نهي، ونُكِّرَ مجرورها، سواء كان ذلك المجرور فاعلاً أم مفعولاً أم مبتدأً[561]، ولا تزاد من في الاستفهام إلّا في سياق (هل) حصراً[562]، وتفيد زيادتها توقّع الجواب بالنفي[563]، وعلى فرض زيادتها (من) فإنّ (هل) دخلت على اسم بعده فعل[564]، فالمعنى لم يختلّ بحذفها. وهنا الذي جاء بعد (من) فاعل قُدّم على فعله؛ لأنّه لو كانت هذه الجملة اسميّة، لجاز دخول الاستفهام بـ(هل) عليها، لكن لما ثبت عدم جواز ذلك فلا ضير في أن يعدّ الاسم المتقدّم فاعلاً تقدّم على فعله لغرض الاهتمام والعناية[565]، فالإمام×في سياق مقامي اشتدّت فيه مجريات المقام، وهي حاجته لنصرة هؤلاء وإغاثتهم. وهنا يطالعنا خرق آخر في الملاءمة مقاميّاً، وهو أنّ الإمام× يعلم مسبقاً بأنّه مقتول ومقطّع الأوصال، كما عرض لأصحابه مواقعهم في الجنّة، قبل ليلة من استشهاده «كُشف لهم الغطاء حتى رأوا منازلهم من الجنّة، فكان الرجل منهم، يقدم على القتل، ليبادر إلى حوراء يعانقها وإلى مكانه من الجنّة»[566]، ثم إنّ الإمام×على يقين بقوله تعالى: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ) فلِم هذا الاستنصار ما دام يعتقد بأنّ الله يغنيه عن الآخرين[567]، وجواب هذا الإشكال يتضح لمن استجلى المقاصد المستلزمة التي خرج إليها هذا الخرق، حيث نرصد مسوّغاته كالآتي:
أـ لا يخفى على جميع من شهد الواقعة منزلة الحسين×الدينيّة والاجتماعية، فهو ابن رسول الله وسيّد شباب أهل الجنّة، بشهادة النبي’.
ب ـ الإمام الحسين×تعامل مع القوم كأفراد يملكون كامل الاختيار بغض النظر عن موقفهم العسكري، وهذا ما سوّغ للإمام×مخاطبتهم.
ج ـ إنّ عامّة من برز لقتال الإمام×ليسوا أعداء مباشرين له، إنّما العدو الحقيقي هم رؤوس السلطة الحاكمة، أمّا الباقون فهم بين مغرّر بهم بالأموال وبين مجبورين بالخوف، وقد وصفهم أكثر من شخص[568] للإمام×بقوله: «يابن رسول الله، قلوبهم معك، وسيوفهم عليك مع بني أمية»[569]. لذا تكون منفعة طلب النصرة راجعة إلى الناصر، لا طالب النصرة؛ أي: الإمام الحسين×، كونه أعلم بمصيره ومصيرهم، فضلاً عن أنّ النصرة لم تتعلّق بالفوز العسكري، بل بالخلاص من النار، ومن التورّط بإراقة دمه الطاهر.
أمّا أهم المقاصد التي انطوى عليها هذا الاستنصار؛ فهي:
ـ طلب النصرة، لم يكن من المتلقّي الحاضر حصراً، وإنّما ممّن يولد من الأجيال القادمة أيضاً.
ـ طلب النصرة ممن عاصروا الحدث غايته تذكيرهم بمسؤوليّتهم الكبرى في الذبِّ عن إمامهم المعصوم، وبذلك يكون موازياً لمضمون ما ورد عن الإمام× بقوله: «من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبّه الله على منخريه في نار جهنّم»[570].
ـ إذا كان الخطاب موجّهاً لأفراد الجيش المعادي، فطلب النصرة منهم يستلزم أولاً أنّ إقامة الحجّة على من سمع الخطاب ولم يجبه، وثانياً يكون سبباً لتوبة من سمع واستجاب لنصرته كما حدث مع الحرّ، والحال أنّهم لم يستجيبوا لأنّهم لم يكونوا مستحقّين التوبة[571].
ـ الاستنصار كان بقصد زيادة رقعة الدم في مسرح الجريمة، والشواهد التاريخية على ذلك كثيرة، مضافاً إلى أنّ طالب النصرة كان يُلوّن ذلك المسرح بنفسه «ثمّ أخذ السهم فأخرجه من قفاه، فانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده على الجرح، فلمّا امتلأت رمى به إلى السماء، فما رجع من ذلك الدم قطرة، وما عرفت الحمرة في السماء حتى رمى الحسين× بدمه إلى السماء، ثمّ وضع يده ثانياً فلمّا امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته، وقال: هكذا أكون حتى ألقى جدّي رسول الله، وأنا مخضوب بدمي»[572]. إذ كلّما زادت كمّية الدماء المراقة في طريق مسيرة الاستشهاد، كثر عدد السامعين لذلك النداء الإصلاحي في الدنيا، واتسع مدى الثورة والاستنهاض[573].
ـ خطاب النصرة كان طلباً لمن يقاتل معه، وليس لمن ينقذه من الموت[574].
أما في خطاب الإمام الحسين×لمروان ابن الحكم بقوله: «يا ابن الزرقاء، أَأَنت تقتلني أم هوَ؟ كذبت والله ولؤُمت»[575]، فقد تغيّر موقع الفاعل، إذ جرى الاستفهام على الضمير (أنت) وليس على الفعل، فالإمام متيقّن من حتميّة وقوع الفعل، وإنّما جاء استفهامه استفهاماً إنكارياً على مروان ابن الحكم من أنّه يستطيع ضرب عنقه، وهذا الاستفهام استلزم قصداً آخر من هذا الاستنكار وهو إخبار مروان والوليد بأنّ قتله واستشهاده لا يتحقّق على يديهما؛ لذلك أنكر عليهما الفعل، وسلّط الاستفهام على الفاعل، كما قد يستلزم ـ أيضاً ـ علمه بمن سيقتله، والدليل على ذلك مجريات السياق المقامي.
ومن موارد تغيير رتبة الفاعل على فعله في سياق الإثبات، تقوية الحكم وإزالة الشك من ذهن السامع كقول القائل (هو يغيث الملهوف) لمن يظنّ أنّه لا يفعل، فجاء تقدّم الفاعل لإزالة الشّك من نفس المتلقّي[576]، وكذلك للحصر والتخصيص[577]. ومنه قول الإمام الحسين× لرسول ابن سعد حينما سأله عن سبب قدومه إلى العراق: «كتب إلىّ أهل مصركم هذا أن أقدم، فأمّا إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم»[578] فاستلزم تقديم الفاعل ـ في كلام الإمام ـ قصد تقوية الحكم وإزالة الشّك والريب من نفس المتلقّي، في أنّه إذا كرهه القوم فإنّه ينصرف ويبتعد عنهم، وإلّا فمقتضى السياق يقول: إذا كرهتموني انصرفت عنكم.
إنّ خرق القاعدة الفرعية يأتي لأغراض قصديّة، وذلك في تقديم المفعول به الذي يحتفظ بموقعية التأخّر عن الفاعل[579]؛ إذ«الأصل في الكلام أن يأتي العامل (الفعل) ويليه المعمول (الفاعل)؛ لأنّه كالجزء من الفعل، ثمّ يأتي المفعول به؛ لأنّه أجنبي بالنسبة للفعل»[580]، إلّا أنّه في بعض الأوقات يخرق المتكلّم هذا الانتظام في الملفوظات لقصد يبتغيه، ومما يقارب هذا الخرق خطاب الإمام الحسين×لعبد الله بن الحرّ الجعفي بقوله: «فإن لم تنصرنا فاتق الله أن تكون ممّن يقاتلنا، والله لا يسمع واعيتنا[581] أحدٌ ثمّ لا ينصرنا إلّا هلك»[582]فمسوّغ الخرق من قبل المتكلّم هو: لما كانت العرب تتحلّى بالشجاعة والمروءة والذبّ عن الحرمات، فهنا أراد الإمام إثارة المشاعر وتحريكها؛ لأهمّية هذه الاعتبارات عند العرب، ولاهتمام الإمام×بها أيضاً، فخرج تقديم المفعول به (واعيتنا) على الفاعل (أحدٌ)[583]، بقصد التحذير والتهديد للحرّ من سماع نداء الاستغاثة والنجدة والذبّ عن الحرمات؛ إذ من غير المعقول أنّ يسمع الحر بواعية الحسين×دون أن ينتفض لنصرته؛ وهذا ما يُفسّر ندمه فيما بعد ندماً شديداً[584].
5ـ تغيير رتبة جواب الشرط على فعل الشرط
وقال× لها‘: «يا أُخيَّة، إِنّي أُقسم عليكِ فأَبرّي قسمي، لا تشقّي عليَّ جيْباً، ولا تَخْمشي عليَّ وجْهاً، ولا تدْعي عليَّ بِالويلِ والثُّبُورِ إِذا أنا هلكْتُ. ثمّ جاء بها حتّى أجلسها عندي»[585]. موضوع الحوار والقصد الذي خرج له هو المواساة لزينب وأهل بيته.
إلّا أنّ من المهم بيان أنّ الإمام×يخرق هذه القاعدة الفرعية بالشقّ الأخير من خطابه الذي خرج إلى المواساة والتعزية لأهل بيته ولأخته زينب، عبر تقديمه جواب الشرط (المؤكّد بالحرف المشبّه بالفعل (إنّ) والمؤكّد بالقسم) على فعل الشرط، يقول: (إنّي أقسم عليك فأبرّي قسمي، لا تشقّي عليّ جيباً، ولا تخمشي عليّ وجهاً، ولا تدعي عليّ بالويل والثبور إذا أنا هلكت). وغاية ما تقتضيه هذه القاعدة الفرعية أن يأتي كلام الإمام×على النحو الآتي: (إذا أنا هلكت لا تشقّي...)ولهذا الخرق في ترتيب سياق الملفوظات مسوّغات، منها:
أولاً: الجمع الغفير من أخواته وأهل بيته اللذين آلمهم أن ينعى الإمام× نفسه.
ثانياً: لسان حال السيدة زينب‘ الذي تمثّل بشقّ الجيب، وأنّها خرّت مغشيّاً عليها، مما جعل الإمام× ـ على تقدير ثبوت هذا الحدث ـ يلتفت إلى أنّ سكوته على هذا الفعل يعد إمضاءً لفعل السيدة زينب‘، ومن أهم هذه المقاصد:
أ ـ رفض الإمام× ـ على تقدير ثبوت هذا الحدث ـ هذا الفعل الدّال على قلّة الصبر والضعف والانكسار، الذي لا يتناسب مع من سيخلفه في قيادة هذه المسيرة المتمثّلة بالسيدة زينب‘بدليل خطابه المباشر لها (لا تشقّي، لا تخمشي، لا تدعي) وإلّا لقال (لا تشقن، لا تخمشن...).
ب ـ تأكيد الإمام×المغلّظ على ترك هذا الفعل وغيره، عن طريق الفعل القضوي الذي دلّت عليه القرينة اللفظية المتمثّلة بـ(أنّ) + (الفعل المضارع أقسم) وفعل الأمر (أبرّي)، والذي استلزم فعلاً لغوياً غير مباشر، خرج إلى قصد المواساة والتعزية لها.
ج ـ هل صدر من السيّدة زينب‘أو باقي النساء هذا الفعل؟ وفي الجواب نقول: إنّ هذه الأفعال التي نهى عنها الإمام×هي مما تعارف عليها من العادات والتقاليد الاجتماعية في حال المصيبة التي يمنى بها أصحابها، ويعضد هذا الرأي قول الإمام السجاد×: «وأمّا عمّتي فلمّا سمعت ما سمعت، وهي امرأة ومن شأن النساء الرقّة والجزع، فلم تملك نفسها أن وثبت تجرّ ثوبها ... حتى انتهت إليه، وقالت: وا ثكلاه...، اليوم ماتت أمّي فاطمة، وأبي علي، وأخي الحسن، يا خليفة الماضي، وثمال الباقي»[586]، أمّا النهي فقد تعلّق بأفعال تجلّ عنها نساء بيت النبوة؛ كونها لا تنسجم مع هدف خروج الإمام× لطلب الإصلاح في أمّة جدّه.
ثالثاً: بيان أهمّية التحلّي بالصبر وإظهار القوّة ـ أمام الأعداء ـ المستمّدة من قوّة الله وعزّته، والذي رشّح لهذا المعنى تكراره للفظ الجلالة المضاف إلى الفعل، (اتقي، تعزّي)، ومن ثمّ هي أهم وأولى عنده من استشهاده×، ما جعله يقدِّم الابتعاد والنهي عن هذه الأفعال، مما يُفضي إلى عدّة نقاط مهمّة جدّاً، وهي من الابتلاءات التي استمرّت حتى وقتنا هذا:
رابعاً: إنّ السيدة زينب‘لم يصدر منها أيّ فعل ينافي ما أكّده الإمام الحسين×بعد هذه الوصيّة التي أوصى بها أهل بيته، بدليل:
أ ـ مقولتها المشهورة عند حضورها بدن أخيها المثخن بالجراحات من دون رأس «اللهم تقبّل منّا هذا القربان».
ب ـ خطابها في أهل الكوفة وفي مجلس عبيد الله بن زياد وردّها عليه ـبعد أن حاول وتجرّأ بإظهار شماتته بقوله: كيف رأيتِ صنع الله بكم، فأجابته بكل شجاعة وثبات وعزّةـبقولها: «ما رأيت إلّا جميلاً».
ج ـ خطابها في أهل الشام، وردّها على تجاوزات يزيد، بعد أن تطاول على الرأس الشريف للإمام الحسين×وأخذ يتمثّل بأبيات ابن الزبعرى:
|
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل |
فقامت زينب بنت علي×، وقالت: «الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله كذلك يقول (ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ)، أظننت ـيا يزيدـحيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أنّ بنا على الله هواناً، وبك على الله كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت إلى عطفك، فمهلاً مهلاً، نسيت قوله تعالى (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)، ثم تقول غير متأثّم:
|
ليت أشياخي ببدر شهدوا |
سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون والحمد لله ربّ العالمين
لقد كانت هذه الدراسة المعتمدة في البحث تسعى لأجل استحصال مقاصد خطاب مسيرة الإصلاح، مسيرة الإمام الحسين وأهل بيته ^ وصحبه رضوان الله عليهم في ضوء إحدى آليات المنهج التداولي، فكانت من ثمار هذه الدراسة بعض النتائج التي استطاع الباحث التوصّل إليها، وهي:
1. استدلّ الباحث على أنّ مفهوم الاستلزام الحواري ليس وقفاً على دراسات غرايس، بل هو مفهوم قديم تناوله قبله جمهرة من الأصوليين والمناطقة.
2. وجد الباحث أنّ ما تحلّت به العملية التخاطبية من توفير لاحترام القواعد أو خرقها، لا تستغني عن قاعدة المناسبة أو العلاقة، فهي قطب الرحى بالنسبة لمبدأ التعاون الغرايسي، إذ المناسبة ضرورية وحتميّة لنجاح التواصل، سواء حصل الخرق أم لم يحصل، ففي خرق قاعدة المناسبة لا بدّ من وجود مناسبة، وهي بمثابة المسوّغ عند بعضهم، ومن وجهة نظر الباحث هي مناسبة، أما القدر المتيقّن مع بقيّة المبادئ والحكم، فهو توفّر المناسبة لتحقيق التواصل.
3. عدم كفاية الدلالة الحرفية لمتوالية النظم في الكشف عن مراد المتكلّم وقصده، من غير التعرّف والإحاطة بمجريات السياق الحالي والمقامي التي أُنتج فيها الخطاب؛ لما له من تأثير كبير في ديمومة عملية التخاطب.
4. توصّل الباحث إلى أنّ دراسة دلالة الجملة، ودراسة أفعال اللغة، لا يشكّلان مجالين مستقلّين، بل مجالاً واحداً؛ فالجملة تعمل دلالياً على خلق سلسلة من الأفعال اللّغوية الخاصّة.
5. إنّ الحوار أو الخطاب عبارة عن سلوك خاضع للقواعد، وما دام كذلك، فإنّه يمتلك سمات صورية ـ كما يعبّر سيرل عن ذلكTrait Formels ـ خاصّة مرتبطة بدراسة مستقلّة.
6. هناك من الخطابات ما لا يمكن فكّ تشفيرها، واستجلاء مقاصدها الدقيقة إلّا على وفق أدوات المنهج التداولي.
7. استدلّ الباحث على مقاصد خطاب المسيرة، ولا يمكن أن تتوقّف على مبدأ التعاون الغرايسي فحسب، بل هناك مبدأ آخر يمكن له أن يعضد مبدأ التعاون، وهو مبدأ التأدّب لروبين لاكوف.
8. فرّق الباحث بين الاستلزام الحواري والاقتضاء التخاطبي، على أنّ الأوّل هو ما يستدلّ عليه من دلالة القول في ظل السياقات الحاليّة والمقاميّة، في حين أنّ الاقتضاء هو استدعاء أمر خارج المنطوق ويكون إما عقلاً أو شرعاً.
9. لا يرى الباحث أهمّية لفصل الدراسات الدلالية عن الدراسات التداولية؛ لغياب الثمرة المتوخّاة للسبب نفسه في النتيجة رقم 3.
10. كذلك يجد الباحث أهمّيةً بالغة في دراسة التراث الإسلامي العربي دراسة تداولية؛ كونها ـأي: التداوليةـأقرب إلى فهم ما وراء النص، حيث تنقل المتلقّي البعيد إلى روح ذلك العصر ومجريات أحداثه، لتمكّنه من دراسة الخطاب ضمن محيطه الذي وُلد وأُنتج فيه، بخلاف استنطاق التراث استنطاقاً شكلياً لا حياة فيه.
11. التقيّد بمقولة الكيف من المتكلّم يؤكّد للمتلقّي صدقه فيما يقول، إذ يُعدّ التصريح بخبر ما حينها، تلويحاً معمّماً، ينبئ عن اعتقاد المتكلّم بصدق الخبر.
12. توصّل الباحث إلى الدقّة والعمق الكبيرين، اللذين تتصف بهما العملية التواصلية بكل أطرفها، من مرسل ورسالة ومرسل إليه وقناة التواصل والظروف الخارجية والداخلية المحيطة التي تكتنف عملية التحاور وتضمن سير عملية التواصل على وفق مبدأ التعاون الإبلاغي وقواعده.
13. لا يكفي إطاعة الكم في تحقيق التواصل، فقد تطيع قاعدة وتخرق أخرى، وهذا ما توصّل إليه الباحث.
* القرآن الكريم.
1. أبحاث في النحو والدلالة، د. السيّد خضر، أستاذ اللّغويات المساعد، جامعة المنصورة، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الأُولى، 1430هـ/ 2009م.
2. إبصار العين في أنصار الحسين×، الشيخ محمّد السماوي(ت1370)، تحقيق: الشيخ محمّد جعفر الطبرسي، مطبعة حرس الثورة الإسلامية، الناشر: مركز الدراسات الإسلامية لممثليّة الولي الفقيه في حرس الثورة الإسلامية، الطبعة الأُولى، رمضان المبارك، 1419/1377هـ.ش.
3. الاحتجاج، الشيخ الطبرسي(ت548هـ)، تحقيق وتعليق: السيّد محمّد باقر الخرسان، دار النعمان للطباعة والنشر، النجف الأشرف ـ العراق، 1966م.
4. الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين الآمدي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1980م.
5. الأخلاق الحسينية، جعفر البياتي، شبكة الإمامين الحسنين÷ للتراث والفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 1418هـ.
6. أدعية الصحيفة السجادية دراسة تداولية، عمّار حسن عبد الزهرة، العتبة الحسينية المقدسة (قسم الشؤون الدينية)، كربلاء ـ العراق، 2017م.
7. الإرشاد، الشيخ المفيد(ت 413هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لتحقيق التراث، الطبعة الثانية، 1414/1993 م.
8. الأزمنة في اللغة العربية، فريد الدين آيدن، دار العِبَر للطباعة والنشر، إسطنبول ـ تركيا، 1997م.
9. الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الخامسة، 1421هـ/2001م.
10.أساليب التأكيد في اللغة العربية، الياس ديب، دار الفكر اللبناني، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1984م.
11.أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، الدكتور قيس إسماعيل الأوسي، (د. ط)، المكتبة الوطنية، بغداد ـ العراق، 1988م.
12.استراتيجيات الخطاب، عبد الهادي بن ظافر الشهري، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأُولى، 2004م.
13.الاستلزام الحواري في التداول اللساني، العياشي أدراوي، الطبعة الأُولى، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1432هـ/2011م.
14.أُسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين ابن الأثير، تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمّد عوض، والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، 1971م.
15.أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني (ت474 أو 471هـ)، قرأه وعلّق عليه: محمود محمّد شاكر، دار المدني بجدّة، مطبعة المدني، القاهرة ـ مصر، (د.ت).
16.أسرار الشهادة، آغا بن عابد الشيرواني الدربندي، شركة المصطفى، البحرين، الطبعة الأُولى، 1994م.
17.الإصابة في تمييز الصحابة، ابن حجر العسقلاني، الطبعة الأُولى، دار العلوم الحديثة، مصر، 1328 هـ.
18.أصول الفقه، محمّد رضا المظفر، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامية، جامعة المدرسين، قم ـ إيران، الطبعة السابعة، 1434هـ.ش.
19.أضواء على ثورة الحسين، السيّد محمّد الصدر، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، الطبعة الأُولى، قم ـ إيران، 1427هـ.
20.أضواء على منبر الصدر، تحقيق وتعليق: عبد الرزاق النداوي، الطبعة الأُولى، مركز الدراسات التخصصية في فكر السيّد الشهيد محمّد الصدر، 1430هـ
21.إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين (مختارات معربة)، المنطق والمحاثة، بول غرايس، ترجمة محمّد الشيباني، المجمع التونسي للعلوم والآدب والفنون بيت الحكمة، 2012م.
22.الأعلام، خير الدين بن محمود الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشرة، بيروت ـ لبنان، 2002م
23.أعيان الشيعة، السيّد محسن الأمين(ت 1371هـ) تحقيق وتخريج: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1403/1983م.
24.آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، الدكتور محمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية، 2002م.
25.الأفعال الانجازية في العربية المعاصرة ( دراسة دلالية ومعجم سياقي)، علي محمود حجي الصرّاف، مكتبة الآداب، الطبعة الأُولى، 2010م.
26.إقبال الأعمال، السيّد ابن طاووس(ت664)، تحقيق: جواد القيومي الإصفهاني، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأُولى، محرم الحرام 1416هـ.
27.الإكسير في علم التفسير، الفقيه العالم الصوفي سليمان عبد القوي بن عبدالكريم الصرصري البغدادي(ت716هـ)، تحقيق عبد القادر حسين، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة الثانية، 2002م.
28.الأمالي، الشيخ محمّد بن علي الصدوق(ت381هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
29.الأمثل في كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2013م.
30.الإنشاء في العربية بين التراكيب والدلالة (دراسة نحوية تداولية)، خالد ميلاد، نشر مشترك، جامعة منوبة، كلّية الآداب، المؤسسة العربية للتوزيع، تونس، الطبعة الأُولى، 2002م.
31.الأنوار العلويّة، جعفر النقدي، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف ـ العراق، الطبعة الثانية، ١٩٦٢م
32.أنواع الربيع في أنواع البديع، علي بن أحمد بن محمّد بن معصوم، تحقيق: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف الأشرف ـ العراق، الطبعة الأُولى، (د.ت).
33.أهل البيت^ في الكتاب والسنّة، محمّد الريشهري، تحقيق: دار الحديث، الطبعة الثانية، 1375ش.
34.الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع، أحمد بن محمّد القزويني (ت739هـ)، وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1424هـ /2003 م.
35.الإيضاح، الفضل بن شاذان الأزدي (ت260هـ)، تحقيق: السيّد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدّث، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان د.ط، مؤسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، 1363 هـ.ش.
36.بحار الأنوار، محمّد باقر المجلسي(ت1111)، تحقيق: محمد الباقر البهبودي، مؤسسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية المصحّحة، 1403هـ/1983م.
37.بحوث لغوية، أحمد مطلوب، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان ـ الأردن، الطبعة الأُولى، 1987م.
38.براهين الحج للفقهاء والحجج، المدني الكاشاني(ت136)، مكتب المنشورات الإسلامية، المدرسة العلمية لآية الله العظمى المدني، كاشان ـ إيران،الطبعة الثالثة، جمادي الأولى 1411هـ.
39.البرهان في تفسير القرآن، السيّد هاشم البحراني(ت1107هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية،مؤسسة البعثة، قم ـ إيران، (د.ت).
40.البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمّد بن عبد الله الزركشي (ت794) تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1425هـ /2004م.
41.بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: د. عبد المتعال الصعيدي، منشورات مكتبة الآداب القاهرة، القاهرة ـ مصر، الطبعة السابعة عشرة، 2005م.
42.بلاغات النساء: ابن طيفور(ت380هـ)، الناشر، مكتبة بصيرتي. قم المقدسة ـ إيران، (د.ت).
43.بلاغة الإمام علي بن الحسين÷، جعفر عباس الحائري، تحقيق: جعفر عباس الحائري، دار الحديث للطباعة والنشر،قم المقدسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1425هـ/1383هـ.ش.
44.بلاغة التراكيب (دراسة في علم المعاني): توفيق الفيل، مكتبة الآداب القاهرة، (د.ط)، (د.ت).
45.البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلامي، د. محمود البستاني دار الفقه للطباعة والنشر، الطبعة الأُولى، 1424هـ.
46.البلاغة العالية (علم المعاني)، عبد المتعال الصعيدي، مكتب الأداب، القاهرة ـ مصر،الطبعة الثانية، 1991م
47.البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها صور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد، عبد الرحمن حسن جنكة الميداني، الطبعة الأُولى، دار القلم، دمشقٍ ـ سورية، 1996م.
48.البلاغة الواضحة، علي الجارم، مصطفى أمين، دار المعارف، 2011م.
49.البلاغة والأسلوبية، محمّد عبد المطلب، مكتبة ناشرون، مصر، الطبعة الأُولى، 1994م.
50.بنية اللُّغة الشعرية، جان كوهين، ترجمة: عبد الولي ومحمّد العمري، دار تويقال للنشر، الدار البيضاء ـ المغرب.
51.البيان والتبيين، الجاحظ(ت255هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر،الطبعة السابعة، 1418هـ/ 1989م.
52.بين المنبر والنهضة الحسينية، مرتضى المطهري، سلسلة وتراث وآثار الشهيد مرتضى مطهري، دار الإرشاد للطباعة والنشر، طهران ـ إيران، الطبعة الأُولى، 2009م.
53.تاريخ الطبري، محمّد بن جرير الطبري(ت310هـ)، تحقيق ومراجعة وتصحيح وضبط: نخبة من العلماء الأجلاء، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ملاحظة: قوبلت هذه الطبعة على النسخة المطبوعة بمطبعة "بريل" بمدينة لندن، 1879م.
54.تاريخ اليعقوبي: اليعقوبي، دار صادر، بيروت ـ لبنان، (د.ط)، (د.ت).
55.التبيان في تفسير القرآن، الطوسي، محمّد بن الحسن، تدقيق وتحقيق وتصحيح: أحمد حبيب قصير، مكتب الإعلام الإسلامي العاملي، الطبعة الأُولى، 1409هـ.
56.التداوليات علم استعمال اللغة، اعداد وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتاب الحديث، الطبعة الأُولى، 1432هـ/2011م.
57.التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن ريبول، وجاك موشلر، ترجمة د. سيف الدين دغفوس، د. محمّد الشيباني، مراجعة د. لطيق زيتوني، دار الطليعة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2003م.
58.التذكرة الحمدونية، ابن حمدون (ت562)، تحقيق: إحسان عبّاس وبكر عبّاس، دار صادر للطباعة والنشر، الطبعة الأُولى، 1996م.
59.ترتيب إصلاح المنطق، ابن السكيت الاهوازي (ت244هـ)، تحقيق ترتيب وتقديم وتعليق: الشيخ محمّد حسن بكائي، مؤسسة الطبع والنشر في استانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد ـ ايران الطبعة الأُولى، 1412هـ.
60.التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية من مكة إلى المدينة، هادي سعدون هنون، (د، ط)، مكتبة العتبة العلوية المقدسة، النجف الأشرف ـ العراق، 1432هـ/ 2011م.
61.التصوير المجازي أنماط ودلالات في مشاهد القيامة في القرآن، أياد عبد الودود، عثمان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ـ العراق، الطبعة الأُولى، 2004م.
62.تعليقة على معالم الأصول، السيّد علي الموسوي القزويني(ت 1298هـ)، تحقيق: السيّد على العلوي القزويني،الطبعة الثانية، 1430هـ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
63.تفسير العياشي، محمّد بن مسعود العياشي، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهران ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1380هـ
64.تفسير القمّي، أبو الحسن علي بن إبراهيم، صححه وعلق عليه وقدم له السيّد طيب الموسوي الجزائري، دار السرور، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1991م
65.تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب، محمّد بن محمّد رضا المشهدي، المكتبة الشاملة، (د.ط).
66.تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين، الطبعة الأُولى، 1415هـ/1995م.
67.تفسير نور الثقلين، الشيخ الحويزي(ت1112هـ)، تحقيق وتصحيح وتعليق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي، مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم ـ إيران،الطبعة الرابعة، 1412 ـ 1370هـ. ش.
68.تنقيح المقال في علم الرجال، عبد الله المامقاني، تحقيق واستدراك الشيخ محيي الدين المامقاني، مؤسسة أهل البيت^ لإحياء التراث، 1351هـ
69.تهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الأُولى، 1993م.
70.الثاقب في المناقب، محمّد بن علي ابن حمزة الطوسي، تحقيق: نبيل رضا علوان،الطبعة الثانية، 1412هـ
71.جامع أحاديث الشيعة، السيّد البروجردي(ت1383)، (د ط)، مطبعة المهر، قم ـ إيران، 1409هـ/ 1367 هـ.ش.
72.جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت(ت1352هـ)، محمود نصار الحلبي ـ شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،الطبعة الثانية، 1381 هـ/1962م.
73.الجنى الداني، أبو محمّد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي، تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة والأُستاذ محمّد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1413هـ/1992م.
74.جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان.
75.جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب×، محمّد بن أحمد الدمشقي الباعوني(ت871هـ)، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم ـ ايران، الطبعة الأُولى، 1416 هـ.
76.حاشية الخضري على ابن عقيل، محمّد بن مصطفى الخضري، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ـ مصر (د.ط)، (د.ت).
77.حاشية الدسوقي على شرح السعد(1230هـ ـ 1815م) مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه، مصر، (د.ت).
78.حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، محمّد بن علي الصبان، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة ـ مصر، المكتبة التوفيقية.
79.الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسة نظرية تطبيقية في البلاغة الجديدة، عالم الكتب الحديث، الطبعة الأُولى، أربد ـ الأردن، 2010م.
80.الحداثة، العولمة، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية، الشيخ محمّد السند، تحقيق: الشيخ علي الأسدي، باقيات ـ وفا، الطبعة الأُولى، 1427هـ /2006م.
81.الحديث النبوي بين الرواية والدراية، الشيخ السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق×، اعتماد، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1419هـ.
82.الحوار ومنهجية التفكير النقدي، حسن الباهي، إفريقيا الشرق، المغرب، 2004م.
83.حياة الإمام الحسين (دراسة وتحليل)، باقر شريف القرشي، قسم الشؤون الفكرية في العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء،الطبعة الثانية، 2008م.
84.الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي#،الطبعة الأُولى، 1409هـ
85.خصائص الأئمة^، السيّد محمّد بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي (الشريف الرضي)(ت 406هـ)، تحقيق وتعليق: الدكتورمحمد هادي الأميني، (د. ط)، مجمع البحوث الرضوية، الاستانة الرضوية المقدسة، مشهد ـ إيران، 1406هـ.
86.الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن جني، تحقيق: محمّد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة ـ مصر، 1952م.
87.الخطاب اللساني العربي ـ هندسة التواصل الاضماري (من التجريد إلى التوليد) توليد المعاني المضمرة وفق انحائها الملائمة، الأستاذ الدكتور بنعيسى أزاييط، أستاذ التعليم العالي، كلّية الاداب والعلوم الإنسانية جامعة مولاي إسماعيل، المغرب، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، الطبعة الأُولى، 2012م.
88.الدر المنثور في التفسير المأثور، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، الرياض ـ السعودية، الطبعة الأُولى، 2015م
89.دستور الصدر مجموعة خطب الجمعة التي القاها السيّد الصدر في مسجد الكوفة، تقرير إسماعيل الوائلي، الطبعة الأُولى، مكتبة دار المجتبى، النجف ـ العراق، 1424هـ/2004م.
90.دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء: د. بتول قاسم ناصر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد ـ العراق، الطبعة الأُولى، 1999 م.
91.دلائل الإعجاز عبد القاهر الجرجاني، قرأه وعلق عليه: محمود محمّد شاكر، مكتبه الخانجي،الطبعة الخامسة، 2004 م.
92.دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، عبد الله بن صالح الفوزان، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض ـ السعودية، الطبعة الأُولى، 1999م
93.ديناميّة النصّ (تنظير وإيجاز)، محمّد مفتاح، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأُولى، 1987م.
94.ديوان النابغة الذبياني، مطبعة الهلال بالفجالة بمصر، (د. ط)، 1911م.
95.رجال الشيخ الطوسي، محمّد بن الحسن الطوسي، تحقيق جواد القيومي الإصفهاني، الطبعة الأُولى، 1415هـ.
96.روح المعاني في تفسير القران والسبع المثاني، شهاب الدين الآلوسي، تحقيق علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان،الطبعة الأُولى، 1415هـ.
97.روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محمّد تقي المجلسي (الأوّل) (1070هـ)، نمقه وعلّق عليه وأشرف على طبعه: السيد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي، الناشر: بنياد فرهنك إسلامي حاج محمّد حسين كوشانپور.
98.روضة الواعظين، الفتال النيسابوري(ت 508)، تحقيق وتقديم: السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الخرسان، الناشر: منشورات الشريف الرضي، قم ـ إيران، (د. ط)، (د. ت).
99.رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين الإمام علي بن الحسين÷، العلامة الأريب والفاضل الأديب السيّد علي خان الحسيني المدني الشيرازي(ت1120هـ) تحقيق: السيّد محسن الحسيني الأمين، مؤسسة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم ـ إيران،الطبعة السابعة، 1432هـ.
100. زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي القرشي البغدادي(ت597هـ)، حققه وكتب هوامشه: محمّد عبد الرحمن عبد الله، خرَّج أحاديثه: السعيد بسيوني زغلول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأُولى، 1407هـ/1987م.
101. زبدة التفاسير، الملّا فتح الله الكاشاني، تحقيق: مؤسسة المعارف، قم إيران، الطبعة الأُولى، 1423ش
102. زهر الآداب وثمر الألباب، إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (ت453هـ) تحقيق مفصل ومضبوط ومشروح بقلم المرحوم: الدكتور زكي مبارك، حققه وزاد في تفصيله وضبطه وشرحه: محمّد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل ـ للنشر والتوزيع والطباعة، مكتبة المحتسب، عمان،الطبعة الرابعة، 1972م.
103. زهر الربيع في شواهد البديع، ناصر الدين محمّد بن قُرْقمَاس، تحقيق: الدكتور مهدي أسعد عرار، دار الكتب العلمية، محمّد علي بيضون، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1428هـ/2007م.
104. زينب والظالمون: محسن المعلّم، دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان،الطبعة الرابعة، 1418هـ/1997م.
105. سنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني(ت275هـ)، تحقيق وتعليق: سعيد محمّد اللحام، الطبعة الأُولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1410هـ/1990م.
106. سير الأعلام، محمّد بن أحمد الذهبي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2004م.
107. السيرة النبوية، ابن هشام الحميري، حققها وشرحها مصطفى السقا ابراهيم الآيباري وعبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، 1975م
108. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ابن العماد العكري الحنبلي، دار ابن كثير، الطبعة الأُولى، 1986م.
109. شرح إحقاق الحق، السيّد المرعشي(ت1411هـ)، تحقيق: السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي، (دط. دت)، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم ـ إيران.
110. شرح الدماميني على مغني اللبيب، الإمام محمّد بن أبي بكر الدماميني (ت828هـ)، صححه وعلق عليه: أحمد عزو عناية، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأُولى، 1428هـ/2007م.
111. شرح الرضي على الكافية، رضي الدين الاسترابادي(ت686هـ)، تحقيق يوسف حسن عمر، 1395هـ/1975م، مؤسسة الصادق، طهران ـ إيران، (د.ط)، وبنغازي ـ ليبيا، منشورات جامعة قار يونس،الطبعة الثانية، 1996م.
112. الشعائر الحسينية بين الاصالة والتجديد، (محاضرات) محمّد السند؛ بقلم: رياض الموسوي، العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء ـ العراق، 1432هـ/ 2011م
113. الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس (ت395هـ)، تحقيق: مصطفى الشويمي ـ بدران للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، 1382هـ/1963م.
114. الصحاح، الجوهري(ت 393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، دار العلم للملايين/ بيروت ـ لبنان،الطبعة الرابعة، 1407هـ/1987م، والطبعة الأولى، القاهرة ـ مصر، 1376هـ/1956م.
115. الصحيح من مقتل سيّد الشهداء وأصحابه، محمّد الري شهري، بمساعدة محمود الطباطبائي نِزاد، روح الله السيّد الطباطبائي، مؤسسة دار الحديث العلمية والثقافية مركز الطباعة والنشر، قم ـ إيران، 1434هـ/ 1392ش.
116. صحيفة الحسين جمع الشيخ جواد القيومي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1374هـ.ش.
117. الصناعتين (الكتابة والشعر)، أبو هلال العسكري، تحقيق علي محمّد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا ـ لبنان، 1986م.
118. عاشوراء ثقافة النهضة والبناء، حسن بن موسى الصفار، دار المحجة البيضاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1434هـ/2013م.
119. علل الشرايع، الشيخ الصدوق(ت381هـ)، تحقيق وتقديم: السيّد محمّد صادق بحر العلوم، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف الأشرف ـ العراق، (د.ط).
120. علم استعمال اللغة، إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي، بحث منال النجار في كتاب التداوليات، عالم الكتاب الجديد، أربد ـ الأردن، 2011م.
121. علم البديع، عبد العزيز عتيق، دار الافاق العربية، الشركة الدولية للطباعة، القاهر ـ مصر، (د. ط)، 1422هـ/2004م.
122. العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني(ت456هـ)، تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة مصر،الطبعة الثالثة، 1383هـ/1963م.
123. العوالم، الإمام الحسين× الشيخ عبد الله البحراني(ت 1130هـ)، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي×،الطبعة الأُولى المحققة، 1407هـ/1365 هـ.ش، المطبعة: أمير، الناشر: مدرسة الإمام المهدي# بالحوزة العلمية، قم ـ إيران.
124. عيون أخبار الرضا، الشيخ محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق(ت381هـ)، صحَّحه وقدَّم له وعلَّق عليه: الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1404هـ/ 1984م.
125. الغدير، الشيخ الأميني(ت 1392هـ)، مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان،الطبعة الرابعة، 1397هـ/ 1977م.
126. فتاوى السبكي، السبكي(756هـ)، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان، (د.ط)، (د.ت).
127. الفتوح: أحمد بن أعثم الكوفي(ت314هـ)، تحقيق: علي شيري، دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1986م.
128. الفروق اللّغوية، أبو هلال العسكري(ت 395هـ)، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي بقم المقدسة، الطبعة الأُولى، شوال المكرم 1412هـ.
129. فقه اللغة وسر العربية، عبد الملك الثعالبي النيسابوري(ت 429هـ)، تحقيق: د. فائز محمّد، مراجعة: د. إميل يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت ـ لبنان،الطبعة الثانية، 1416 /1996 م.
130. فلسفة البلاغة بين التقنية والتطوير، رجاء عيد، منشآت المعارف، مصر. الطبعة الثانية، 1988م
131. الفلسفة واللغة ـ نقد المنعطف اللّغوي في الفلسفة المعاصرة، د. الزواوي بغورة، دار الطليعة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2005م.
132. في النحو العربي.. نقد وتوجيه، الدكتور مهدي المخزومي، دار الشؤون الثقافية العامة،الطبعة الثانية، بغداد ـ العراق، 2005م.
133. في رحاب عاشوراء، الشيخ محمّد مهدي الآصفي، مجمع أهل البيت^ في العراق، النجف الأشرف ـ العراق،الطبعة الثانية، 1429 هـ/2008م.
134. في ظلال نهج البلاغة، محمّد جواد مغنية، مطبعة ستار، انتشارات كلمة الحق، الطبعة الأُولى، 1427هـ.
135. في نظرية الأدب وعلم النص بحوث وقراءات، إبراهيم خليل، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الطبعة الأُولى، 2010م.
136. القاموس الموسوعي للتداولية، جاك موشلر ـ آن ريبول، ترجمة: مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين المجدوب، المركز الوطني للترجمة تونس، دار سيناترا، 2010م.
137. قوانين الخطاب، أوزالد ديكرو، ترجمة: محمّد الشيباني وسيف الدين دغفوس، المجمع التونسي للعلوم والآدب والفنون، بيت الحكمة، 2012م
138. الكافي، الشيخ الكليني، تحقيق وصححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري دار الكتب الإسلامية، طهران ـ ايران،الطبعة الرابعة، زمستان 1365هـ.ش.
139. كامل الزيارات، الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه القمي(ت368هـ)، تحقيق: جواد القيومي، لجنة التحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي،الطبعة الأُولى، 1417هـ.
140. الكامل في التاريخ، ابن الأثير(ت630هـ)، دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر، 1386هـ/1966م.
141. كتاب الأفعال، أبو بكر محمّد ابن القوطية، تحقيق: علي فودة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ـ مصر،الطبعة الأُولى، 1952م.
142. كتاب الحيوان، أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ(ت255هـ)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر، الطبعة الأُولى، 1356هـ ـ 1938م.
143. كتاب العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت175هـ)، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور ابراهيم السامرائي، الناشر: مؤسسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، 1410هـ.
144. كتاب سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب بسيبويه(ت180هـ)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،الطبعة الثالثة، 1408هـ/1988م، والطبعة الأُولى، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، 1425هـ/ 2004م.
145. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري(ت 538هـ)، الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، عباس ومحمد محمود الحلبي وشركاهم، خلفاء، (د. ط)، 1385هـ ـ 1966م.
146. لسان العرب، محمّد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري(ت711هـ)، نشر أدب الحوزة، قم، (د. ط)، 1405هـ.
147. اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي للنشر، الطبعة الأُولى، 1998م.
148. اللسانيات الوظيفيّة المقارنة (دراسة في التنميط والتطوير)، أحمد المتوكل، دار الكتاب الجديد،الطبعة الثانية، 2010م
149. اللسانيات الوظيفية المقارنة دراسة في التنميط والتطور، أحمد المتوكل، دار الأمان الرباط، منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، الطبعة الأُولى، 2012م.
150. لغة الإعراب، بدير متولي حميد، دار المعرفة، القاهرة، (د.ط)، (د.ت).
151. اللغة العربية معناها ومبناها، الدكتور تمّام حسّان، عالم الكتب، القاهرة ـ مصر،الطبعة الرابعة، 1425هـ /2004م.
152. اللغة، جوزيف فندريس، تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، (د. ط)، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة ـ مصر، 1370هـ/ 1950م.
153. لماذا اخترت مذهب أهل البيت، الشيخ محمّد مرعي الأنطاكي (ت1383هـ)، تحقيق الشيخ عبد الكريم العقيلي، من مؤلفات المستبصرين، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأُولى، 1417/1375هـ. ش.
154. اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس، مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان،الطبعة الأُولى، 1993م
155. لواعج الأشجان، محسن الأمين، تحقيق: السيّد حسين الأمين، دار الأمير، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1996م.
156. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لضياء الدين بن الأثير، قدمه وعلق عليه: دكتور احمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الفجالة، القاهرة ـ مصر، (د.ت).
157. مثير الاحزان، ابن نما الحلي(ت645هـ) المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف ـ العراق، 1369/1950م.
158. المجالس العاشورية في المآتم الحسينية، الشيخ عبد الله ابن الحاج حسن آل درويش، ستاره، انتشارات أهل الذكر، قم ـ ايران، الطبعة الأُولى، 1428هـ.
159. مجمع الأمثال، أبو الفضل أحمد بن محمّد الميداني النيسابوري، تحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت ـ لبنان.
160. مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (ت1085هـ)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، مكتب نشر الثقافة الإسلامية،الطبعة الثانية، 1408هـ.
161. مجمع الزوائد، الهيثمي، (ت 807 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، د. ط، 1408/1988م.
162. محاضرات في فلسفة اللغة، عادل فاخوري، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2013م.
163. المحلى بالآثار، ابن حزم الأندلسي(456هـ) دار الفكر، بيروت ـ لبنان، (د.ط)، (د.ت).
164. مدخل إلى الدراسة التداولية، مبدأ التعاون ونظرية الملاءمة والتأويل، فرانثيسكو يوس راموس، ترجمة وتقديم: يحيى حمدان، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع العراق، الطبعة الأُولى، 2014م.
165. مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ودلائل الحجج على البشر، السيّد هاشم البحراني، الشيخ عزة الله المولائي الهمداني، دار المعارف الإسلامية، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1413م.
166. مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، عبد الله ابن أسعد اليافعي اليمني، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، 1997م.
167. مسند ابن المبارك، عبد الله بن المبارك(ت 181هـ)، تحقيق: د. مصطفى عثمان محمد، مصادر الحديث السنية ـ القسم العام، الطبعة الأُولى، 1411 ـ 1991 م.
168. مصباح الهداية في إثبات الولاية، السيّد علي البهبهاني(ت 1350)، تحقيق وإشراف: رضا الأستادي الناشر: مدرسة دار العلم ـ أهواز، المطبعة: سلمان الفارسي، قم ـ إيران،الطبعة الرابعة، 1418هـ.
169. معالم المدرستين، السيّد مرتضى العسكري، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1410هـ/1990 م.
170. معاني النحو فاضل السامرائي، دار احياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1428هـ /2007م.
171. المعتبر في شرح المختصر، جعفر بن الحسن الحلّي، مؤسسة سيّد الشهداء، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1407 ق
172. المعجم الأصولي، الشيخ محمّد صنقور علي، مطبعة عترت، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1421هـ.
173. المعجم الكبير، الطبراني(ت360هـ)، تحقيق وتخريج: حمدي عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، (د.ط)، (د.ت).
174. المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، صنفه د. علي توفيق الحمد، يوسف جميل الزغبي، دار الامل،الطبعة الثانية، 1993م.
175. معجم رجال الحديث، السيّد الخوئي(1413هـ)،الطبعة الخامسة، 1413هـ /1992م.
176. معجم مقاييس اللغة، لأبي أحمد بن فارس بن زكريا395هـ، تحقيق وضبط: عبد السلام محمّد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط)، (د.ت).
177. مغامرة النص من النحو إلى التداولية، قراءة في شروح التلخيص، للخطيب القزويني، صابر حباشة الاصدار الأوّل، صفحات للدراسة والنشر، دمشق ـ سورية، 2011م.
178. مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب، الإمام أبي محمّد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري، المصري( ت761هـ)، تحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدائني ـ القاهرة،الطبعة الأُولى، (د.ت).
179. مفتاح العلوم، يوسف بن محمّد بن علي السكّاكي (ت 626هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1420هـ/2000م.
180. مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني (ت425هـ)، تحقيق: صفوان عدنان داوودي، سليمان زاده، طليعة النور،الطبعة الثانية، 1427هـ.
181. مقاتل الطالبيين أبي فرج الاصفهاني(ت610هـ)، تحقيق، تقديم وإشراف: كاظم المظفر، الناشر: منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها، النجف الأشرف ـ العراق،الطبعة الثانية، 1385/1965م.
182. المقتصد في شرح الإيضاح، الشيخ عبد القاهر الجرجاني(ت471هـ)، تحقيق: الدكتور كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، (د.ط)، 1982م.
183. المقتضب، أبو العباس محمّد بن يزيد المبرد، تحقيق محمّد عبد الخالق عظيمة، القاهرة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،الطبعة الثانية، 1415هـ/1994م.
184. مقتل الحسين، السيّد عبد الرزاق المقرم منشورات النور بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1423هـ/2002م.
185. مقتل الحسين×، أبو مخنف الأزدي(ت 157هـ)، تحقيق وتعليق: حسين الغفاري،( د.ط)، (د.ت)، مطبعة العلمية، قم ـ إيران.
186. مقتل الحسين×، الموفق بن أحمد المكّي الخوارزمي، مؤسسة أنوار الهدى، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1418 هـ
187. الملحمة الحسينية، الشيخ مرتضى المطهري، تعريب: السيّد محمّد صادق الحسيني، الدار الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان،الطبعة الرابعة، 1429هـ/2008م.
188. من أخلاق الإمام الحسين×، عبد العظيم المهتدي البحراني، انتشارات شريف الرضي، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1421هـ /2000م.
189. مناقب آل أبي طالب، ابن شهرآشوب(ت588هـ)، تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، (د. ط)، المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف ـ العراق، 1376هـ/1956م.
190. مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، محمّد بن سليمان الكوفي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، 1412 هـ
191. منبر الصدر، السيّد محمّد صادق الصدر، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1427هـ.
192. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، عبد الرحمن ابن الجوزي،الطبعة الثانية، 1995م.
193. مواهب الفتاح على تلخيص المفتاح، جلال الدين القزويني، ابن يعقوب المغربي(ت1168هـ)، المكتبة العصرية، (د.ط)، 2006م.
194. موسوعة شهادة المعصومين ^لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، اعتماد، قم ـ إيران، انتشارات نور سجا، الطبعة الأُولى، 1381ش.
195. موسوعة كلمات الحسين×، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، دار المعروف للطباعة والنشر،الطبعة الثالثة، 1416/1995 م.
196. موسوعة من حياة المستبصرين، مركز الأبحاث العقائدية، الطبعة الأُولى، 1430هـ.
197. الميزان في تفسير القرآن، محمّد حسين الطباطبائي، مؤسسة الإمام المنتظر#، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1425هـ/2004م.
198. نثر الدّر في المحاضرات، سعد منصور الآبي، تحقيق خالد عبد الغني محفوظ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2004م
199. النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، 1974م.
200. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، الحلواني، مدرسة الإمام المهدي#، قم المقدسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1408هـ
201. النص والسياق، فان دايك، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، بيروت ـ لبنان، 2000م.
202. النصائح الكافية، سيّد محمّد بن عقيل العلوي(ت 1350هـ) المجموعة: مصادر سيرة النبي’ والائمة^، دار الثقافة للطباعة والنشر، الطبعة الأُولى، قم ـ إيران، 1412هـ.
203. نظرية التلويح الحواري، بين علم اللغة الحديث والمباحث اللّغوية في التراث العربي والإسلامي، هاشم عبد الله الخليفة، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة العالمية للنشر لونجمان، الطبعة الأُولى، 2013م.
204. نظرية الصلة أو المناسبة في التواصل الإدراكي، دان سبيربر وديدري ولسون، ترجمة: هاشم عبد الله الخليفة، دار الكتاب الجديد المتحدة، الطبعة الأُولى، 2016م.
205. نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس، صلاح اسماعيل، الدار المصرية السعودية، القاهرة ـ مصر، الطبعة الأُولى، 2005م.
206. نهج البلاغة، خطب الإمام علي×، تحقيق وشرح: الشيخ محمّد عبده، دار الذخائر، الطبعة الأُولى، قم ـ إيران، 1412هـ/1370هـ. ش.
207. الهداية في الأصول والفروع، محمّد بن علي الصدوق، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي#، الطبعة الأُولى، 1418هـ
208. همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، جلال الدين السيوطي(ت911هـ)، تصحيح محمّد بدر الدين النعساني، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، (د. ت).
209. الوظائف التداولية في اللغة العربية، أحمد المتوكل، الدار البيضاء المغرب، دار الثقافة، الطبعة الأُولى، 1405هـ
210. ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي(ت1294هـ) مصادر سيرة النبي’ والائمة^، تحقيق: السيّد علي جمال أشرف الحسيني، مطبعة أسوه، الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر، الطبعة الأُولى، 1416هـ.
211. أساليب الاستفهام في القرآن الكريم، فودة عبد العليم السيد، (رسالة ماجستير)، نشرت ككتاب من قبل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية، جامعة القاهرة، 1953م.
212. أساليب التعجب في القرآن الكريم ـ دراسة دلالية، حاتم حسين علي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلّية الآداب، 1419هـ/1998م.
213. الجمل في النحو لأبي بكر أحمد بن الحسن بن شقير النحوي البغدادي
(ت 317هـ)، تحقيقاً ودراسةً، علي بن سلطان الحكمي، (رسالة ماجستير) بكلّية الشريعة
والدراسات الإسلامية، جامعة الملك عبد العزيز، (د.ت).
214. خطب سيدات البيت العلوي حتى نهاية القرن الأوّل الهجري، (دراسة موضوعيّة فنّيّة) زينب عبد الله كاظم الموسوي (رسالة ماجستير)، جامعة الكوفة، كلّية الآداب.
215. شعر أبي نواس دراسة تداولية، أطروحة دكتوراه تقدم بها الطالب حسين عمران محمد، لجامعة ديالى، كلّية التربية للعلوم الإنسانية، 1436هـ/ 2015م.
216. طرق التضمين الدلالي والتداولي في اللغة العربية وآليات الاستدلال، إدريس سرحان، أطروحة دكتوراه، اللغة العربية وآدابها، جامعة السيّد محمّد بن عبد الله، فاس، 2000م.
217. كلام الإمام الحسين مقاربة تداولية، عماد طالب موسى جاسم، (رسالة ماجستير) كلّية التربية جامعة كربلاء، 1438هـ/2017.
218. المعنى المضمر في الخطاب اللغوي العربي والقيمة التنجيزية: مقاربة تداولية لسانية (أطروحة دكتوراه الدولة)، أزاييط بنعيسى.
219. نثر الإمام الحسين× دراسة بلاغية، ميثم قيس مطلك، (رسالة ماجستير) آداب اللغة العربية، كلّية التربية ـ جامعة القادسية، 1427هـ/ 2006م.
220. الوظيفة في كتاب سيبويه، رجاء عجيل إبراهيم، أطروحة دكتوراه تقدمت بها الباحثة لجامعة كربلاء، 1434هـ/2013م.
221. أثر كربلاء في خطابة آل البيت والتوابين ـ رؤية عناصر الواقعة واللُّغة الفنّيّة، بحث منشور في مجلّة المنهاج، عدد5 ـ 6، السنة الثانية.
222. اسم الفعل دراسة وتيسير، د. سليم النعيمي، بحث منشور في مجلّة المجمع العلمي العراقي، مجلد 16، 1969م.
223. الأفعال الكلامية عند الأصوليين، دراسة في ضوء اللسانيات التداولية، مسعود صحراوي مجلّة اللغة العربية، مجلّة نصف سنوية، عدد10، الأبيار ـ الجزائر، خريف 2014م.
224. بحث ظاهرة الاستلزام التخاطبي في التراث اللساني، أ. كادة ليلى، مجلّة علوم اللغة العربية وآدابها، العدد الأوّل، 2009م
225. بحث نظرية كرايس والبلاغة العربية، أزاييط بنعيسى، مجلّة كلّية الآداب، مكناس، عدد 13، 1999م.
226. بحث وظائف البعثات الدبلوماسية، عبد الحكيم سليمان وادي، المبحث الثاني الوظيفة الدبلوماسية:https: //llpulpit. alwatanvoice.Com /articles.
227. التحليل التداولي للخطاب السياسي، ذهبية حمو الحاج، مجلّة الخطاب، عدد1، 2006م.
228. التداولية في البحث اللّغوي النقدي، مجموعة من الباحثين، تحرير،
د. بشرى البستاني، مجلّة الآن، العدد3، مؤسسة السياب للطباعة والنشر والتوزيع،
لندن ـ بريطانيا، الطبعة الأولى، 2015م.
229. الثقافة العربية وعصر المعلومات: د. نبيل علي، سلسلة عالم المعرفة، عدد265، الكويت، يناير2001م.
230. القصدية من فلسفة العقل إلى فلسفة اللغة، الأستاذة وشن دلال، مجلّة كلّية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمّد خضير، بسكرة ـ الجزائر، جانفي، عدد6، 2010م.
231. مقدمة في علم التفاوض السياسي والاجتماعي، حسن محمّد وجيه، عالم المعرفة، عدد190.
232. نحو مقاربة حجاجية للاستعارة، أبو بكر العزاوي، مجلّة المناظرة، المغرب، السنة الثانية، عدد4، شوال 1411 هـ/1991 م.
233. نظرية السياق بين التوصيف والتأصيل والاجراء، دور السياق في حل مشكلات المعنى، عبد القادر بن فرح، مجلّة الآن، عدد5، الطبعة الأولى، 2015م.
المصادر الاجنبية
234. H.P GRICE, (Logic and conversation), in conditionals،,Edited by Frank Jackson، chapter 8, Oxford University press، New York 1991
235. Jackson، chapter 8، pp. 155 ـ 175. Oxford University press, New York 1991
[1] البقرة: آية31.
[[2]][2] المجادلة: آية11.
[[3]][3] البقرة: آية129.
[4] آل عمران: آية164.
[5] الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
[6] البقرة: آية253.
[[7]][7] يُنظر: أبو الفتح، عثمان بن جني، الخصائص: ج1، ص44.
[8] الجاحظ، عمر بن بحر، الحيوان: ج3، ص131 ـ 132.
[9] الجاحظ، عمر بن بحر، البيان والتبيين: ج1، ص76.
[10] كأرسطو طاليس، والشوكاني، والآمدي في الأصول والبلاغة.
[11] يُنظر: د. صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب: ص21.
[12] يُنظر: المصدر نفسه، ص22، ويُنظر: د.بغورة، الزواوي، الفلسفة واللغة (نقد المنعطف اللّغوي في الفلسفة المعاصرة): ص202.
[13] يُنظر: د. صحراوي، مسعود، التداولية عند العلماء العرب: ص23.
[14] يُنظر: د.بغورة، الزواوي، الفلسفة واللغة (نقد المنعطف اللّغوي في الفلسفة المعاصرة): ص104.
[15] يُنظر: بحث منال النجار في كتاب التداوليات علم استعمال اللغة، ضمن بحث مفهوم البراغماتية ونظرية المقام: ص63.
[16] الصواب: إذاً.
[17] الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ص49.
[18] يُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج7، ص372، (لزم).
[19] ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج12، ص541، (لزم).
[20] العسكري، أبو هلال، الفروق اللّغوية: ص464.
[21] ومن هنا جاءت تسمية الحائر الحسيني بهذه التسمية ـ والذي نحن بصدد دراسة الاستلزام الحواري لخطب مسيرته الخالدة× ـ لأنّ الماء الذي فتحه المتوكّل على قبر الإمام الحسين× حار واستدار. يُنظر: الذهبي، محمّد بن أحمد، سير أعلام النبلاء: ج1، ص317.
[22] الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): ج2، (حور). 638. والأهوازي، ابن السكيت، ترتيب إصلاح المنطق: ص 135.
[23] صلاح إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس: ص16، يُنظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص17.
[24] المصدر نفسه: ص13، ويُنظر: غرايس، بول، المنطق والمحاثة، ترجمة محمّد الشيباني، ضمن إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين (مختارات معرّبة): ج2، ص611.
[25] يُنظر: صلاح إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس: ص78، يُنظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص17.
[26] المظفر، محمّد رضا، أصول الفقة: ج1ص131.
[27] الخليفة، هاشم عبد الله، نظرية التلويح الحواري: ص43.
[28]يُنظر: صلاح إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول غرايس: ص78.
[29]العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص98.
[30]يُنظر: جاك موشلر ـ آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين المجدوب: ص214.
[31] يُنظر: فلسفة اللغة والمنطق دراسة في فلسفة كواين، نقلاً عن القصدية من فلسفة العقل إلى فلسفة اللغة، الأستاذة وشن دلال، مجلّة كلّية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة محمّد خضير ـ بسكرة (الجزائر) جانفي: ع6، 2010م: ص35 ـ 36.
[32] يُنظر: المرجع نفسه: ص36. وآن ريبول، وجاك موشلر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة د. سيف الدين دغفوس، د. محمّد الشيباني: ص53.
[33]د. نحلة، محمود أحمد، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر: ص33.
[34] آن ريبول، وجاك موشلر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة د. سيف الدين دغفوس، د. محمّد الشيباني: ص56.
[35] المصدر السابق: ص34.
[36] وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الاستلزام أقرب إلى الاستقراءInduction منه إلى الاستنباط Deduction أو الاستلزام المنطقيEntailment، أو القياس الأرسطي، القائم على وجود مقدّمتين (كبرى وصغرى) تستبطنان نتيجة منطقيّة حتميّة غير قابلة للنقض، فلو قلنا: محمّد إنسان (صغرى)، كل إنسان فانٍ (كبرى)، إذن: محمّد فانٍ (النتيجة) ففي حال صدق المقدّمتين الصغرى والكبرى فإنّ النتيجة وهي: الموت، استلزم عنهما لا محالة. على عكس الاستقراء القابل للإلغاء والانخرام والمسامحة اللّغوية البعيدة عن التشدّد العقلي، إذ لو قال أحدهم: رأيت آلاف النساء، وكل امرأة شاهدتها كانت جميلة، لذلك فإنّ كل النساء في العالم جميلات. ومن خلال هذا الاستقراء القابل للنقض عن طريق رؤية هذا الشخص لامرأة قبيحة ستبطل النتيجة التي حصلت من الاستقراء، وتكون غير صالحة للتعميم. يُنظر: الخليفة، هاشم عبد الله، نظريّة التلويح الحواري: ص39.
[37] المصدر السابق: ص26.
[38] فاخوري، عادل، محاضرات في فلسفة اللغة: ص39، الخليفة، هاشم عبد الله، نظريّة التلويح الحواري: ص34.
[39] المصدر السابق.
[40] ابن فرح، عبد القادر، نظريّة السياق بين التوصيف والتأصيل والإجراء، دور السياق في حل مشكلات المعنى، مجلّة الآن، العدد الخامس: ص321.
[41] يُنظر: إبراهيم خليل، في نظريّة الأدب وعلم النص، بحوث وقراءات: ص304.
[42] الخطيب القزويني، مغامرة النص من النحو إلى التداولية: ص148.
[43] يُنظر: الخطيب القزويني، مغامرة النص من النحو إلى التداولية: ص148.
[44] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص28.
[45] يُنظر: فاخوري، عادل، محاضرات في فلسفة اللغة: ص40 ـ 41.
[46] يُنظر: المصدر نفسه: ص40 ـ 41.
[47] يُنظر: القزويني، علي الموسوي، تعليقة على معالم الأصول، السيّد علي الموسوي القزويني: ج4، ص332، والمدني الكاشاني، براهين الحج للفقهاء والحجج: ج3، ص98.
[48] مقام البيان: هو أصل عقلائي يقضي بأن يكون المتكلّم في مقام الإفصاح عن مرامه ومقصوده، وليس في مقام الإهمال والإجمال، إذ لو كان كذلك لم يكن من الممكن استظهار إرادة الإطلاق بعد أن لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة، والمراد من وجوب إحراز أنّ المتكلّم في مقام البيان هو إحراز أنّه بصدد بيان تمام مراده في الجهة التي هو متصدّ لبيانها، فليس المراد من ذلك هو لزوم إحراز أنّه بصدد البيان من تمام الجهات، إذ أنّ ذلك قد لا يتفق للمتكلّم، كما أنّ عدم كونه في مقام البيان لا يعني أنّه ليس بصدد التفهيم ولو إجمالاً، بل يعني أنّه ليس بصدد بيان تمام مراده في الجهة المفترض تصدّيه لبيانها، أو أنّه أجمل وأهمل ما يفترض تصدّيه لبيانه، ومثاله قوله تعالى: (وكلوا مما أمسكن عليه) فقد استفاد منه البعض الإطلاق... يُنظر: صنقور، محمد، المعجم الأصولي: ص805 ـ 806.
[49] يُنظر: الخليفة، هاشم عبد الله، نظرية التلويح الحواري: ص57.
[50] الأنصاري، عبد الله بن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ج1، ص193.
[51] الأنصاري، عبد الله بن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ج1، ص193.
[52] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص118.
[53] المرعشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج12، ص127.
[54] يُنظر: جاك موشلر ـ آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين المجدوب: ص206.
[55] يُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ص348 باب الكاف والثاء والراء. وابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص131 مادة (كثر).
[56] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص200. والطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص30.
[57] ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص564.
[58] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص131. ويُنظر: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية: ج5، ص212.
[59] الجمعة: آية8.
[60] جميل الزغبي، علي توفيق، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي: ص136.
[61] السامرائي، فاضل، معاني النحو: ج4، ص122.
[62] الزمخشري، محمود بن عمر، الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ص321.
[63] يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان، كتاب سيبويه: ج1، ص189. ويُنظر: السامرائي، فاضل، معاني النحو: ج4، ص122.
[64] الأنصاري، عبد الله بن هشام، مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب: ص62.
[65] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص128. الخوارزمي، الموفق بن أحمد المكّي، مقتل الحسين: ج1، ص357 ـ 358. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص7.
[66] المرعشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج11، ص647.
[67] الأنصاري عبد الله بن هشام،، مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب،: ص62.
[68]الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص323
[69] الدماميني، محمّد بن أبي بكر، شرح الدماميني على مغني اللبيب: ج2، ص87.
[70] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص129. ابن حمدون، التذكرة الحمدونية: ج5، ص212.
[71] يُنظر: جاك موشلر ـ آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، ترجمة: مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين المجدوب: ص213. فاخوري، عادل، محاضرات في فلسفة اللغة: ص40.
[72] يُنظر: فاخوري، عادل، محاضرات في فلسفة اللغة: ص42 ـ 44. الخليفة، هاشم عبد الله، نظرية التلويح الحواري: ص36.
[73] الأنصاري، عبد الله بن هشام، مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب: ص78.
[74] يُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان، كتاب سيبويه: ج1، ص22.
[75] يُنظر: المبرّد، محمّد بن يزيد، المقتضب: ج4، ص276.
[76] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص317، أبو مخنف الأزدي، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص107. ويُنظر: العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص90.
[77] السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن: ج1، ص190.
[78] (وروى إبراهيم بن سعيد، وكان قد صحب زهيراً حينما مضى إلى الإمام، أنّه×قال له ـ يعني زهير ـ: إنّه يقتل في كربلاء، وإنّ رأسه الشريف يحمله زجر بن قيس إلى يزيد، يرجو نواله فلا يعطيه شيئاً). يُنظر: المهتدي البحراني، عبد العظيم، من أخلاق الحسين×: ص 188.
[79] تنقيح المناط: مصطلح أصولي، مركّب من التنقيح وتعني: التنقية والتهذيب والتمييز، يقال: نقّحت الشيء أي: خلّصته من الشوائب، ونقّحت الحنطة أي: خلّصت جيّدها من رديئها. ومن المناط وهو: اسم لموضع التعليق، فيقال: ناطه نوطاً، أي: علّقه، ونياط القربة عروتها، وشجرة ذات أنواط أي: ذات أغصان يمكن أن تعلّق عليها الثياب والسيوف بواسطة حبائلها. ولهذا يطلق لفظ المناط ويراد منه العلّة لتعلّق الحكم بها، وعليه يكون معنى المصطلح: هو تمييز علّة الحكم عن سائر الأوصاف والحيثيات المذكورة في الخطاب، وبتمييزها يمكن الاستفادة من العلّة لإثبات الحكم لموضوعات أخرى غير الموضوع المخصوص عليه في الخطاب. يُنظر الهامش أعلاه.
[80] صنقور، محمد، المعجم الأصولي: ص453.
[81] المصدر نفسه: ص453.
[82] فاخوري، عادل، محاضرات في فلسفة اللغة: ص43.
[83] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17، ويُنظر: الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص25، ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص14، المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص325.
[84] يُنظر: عبّاس حسن، النحو الوافي: ج1، ص632.
[85] النابغة الذبياني، زياد بن معاوية، ديوان النابغة الذبياني: ص13. يُنظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع: ص383.
[86] يُنظر: فاخوري، عادل، محاضرات في فلسفة اللغة: ص43.
[87] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص24.
[88] يُنظر: تمّام حسّان، اللغة العربية معناها ومبناها: ص156 ـ 160.
[89] Jackson، chapter 8، pp.155 ـ 175.Oxford University press، New York 1991.
بول غرايس، المنطق والمحادثة، ترجمة: محمّد الشيباني وسيف الدين دغفوس، ضمن إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين (مختارات معرّبة): 2/619. طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص310 ـ 313.
[90] العزاوي، أبو بكر، نحو مقاربة حجاجية للاستعارة، مجلّة المناظرة، المغرب، السنة الثانية، العدد4، شوال 1411 هـ/1991 م: ص81.
[91] يُنظر: H.P GRICE, (Logic and conversation), in conditionals، Edited byFrank Jackson، chapter 8، pp. 155 ـ175. Oxford University press، New York 1991.
بول غرايس، المنطق والمحادثة ترجمة محمّد الشيباني وسيف الدين دغفوس، ضمن إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين (مختارات معرّبة): ج2، ص625.
[92] يُنظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص34.
[93] يُنظر: المرجع نفسه: ص99. ويُنظر: بحث نظرية كرايس والبلاغة العربية، أزاييط بنعيسى، مجلّة كلّية الآداب، مكناس، عدد 13، 1999م.
[94] طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص310 ـ 313.
[95] العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص99 ـ 100.
[96] يُنظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص99.
[97] يُنظر: بول غرايس، المنطق والمحاثة، ترجمة: محمّد الشيباني وسيف الدين دغفوس، ضمن اطلالات على النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين (مختارات معرّبة): ج2، ص619. وفاخوري، عادل، محاضرات في فلسفة اللغة: ص45.
[98] أوزالد ديكرو، قوانيين الخطاب، ترجمة: محمّد الشيباني وسيف الدين دغفوس (مختارات معرّبة): ج2، ص565.
[99] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص21. الخوارزمي، الموفق بن أحمد المكّي، مقتل الحسين×: ج1، ص188.
[100] أقصد ليس فيها نسبة للمحاباة وللمجاملة، لأنها عبارات جاءت بكل ما تحملة العبارة من حمولة لمعنى الصدق، ولم أقصد عبارات صادقة في قبال وجود عبارات كاذبة ـ استغفر الله ـ .
[101] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص122. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص94. مع اختلاف في بعض الألفاظ، مثل: رضي الله عنه وعليه السلام.
[102] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص122. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص94.
[103] يُنظر: أزاييط، بنعيسى عسو، الخطاب اللساني العربي ـ هندسة التواصل الإضماري (من التجريد إلى التوليد) توليد المعاني المضمرة وفق أنحائها الملائمة: ج3، ص116.
[104] سيتضح ذلك في الشطر الثاني من المحاورة الذي سيبيّنه الباحث في خرق قاعدة المناسبة في الفصل الثالث ـ إن شاء الله ـ .
[105] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج1، هامش341. يُنظر: المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج31، ص97.
[106] طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص228.
[107] الأحزاب: آية33.
[108]] ) «ولما كان غرايس بمبدئه التعاوني قد جمد على النظر في الجانب التبليغي من التخاطب، فقد لزمنا مبدأ يجمع إلى عنصر التبليغ عنصر التهذيب» طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص240.
[109] المصدر نفسه، ص228
[110] العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص123.
[111] علي الجارم ـ مصطفى أمين، البلاغة الواضحة: ص217.
[112] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ص527.
[113] يُنظر: ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج10 ـ مادّة فسق. والطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج5، ص227 ـ 228، مادّة فسق.
[114] الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، صور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد: ج1، ص528.
[115] أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقاتل الطالبيين: ص78. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص51.
[116] وهذا الرجل قيل: هو محمّد بن الأشعث، وقيل: هو الشمر. يُنظر: الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص151، المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص31.
[117] ابن الأثير، علي بن أبي كرم، الكامل في التأريخ: ج4، ص66. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ج604.
[118] يُنظر: كلام الإمام الحسين مقاربة تداولية: ص46.
[119] أزاييط، بنعيسى عسو، الخطاب اللساني في هندسة التواصل الإضماري: ج3، ص114.
[120] وهنا خرق المتكلّم قاعدة الكيف بتقديم أخبار لا صحّة لها، ولا يمتلك دليلاً عليها، وهذا ما سيتّضح في الفصل الثاني من الرسالة.
[121] الدخان: آية49.
[122] المرادي، بدر الدين حسن بن قاسم، الجنى الداني: ص235.
[123] أزاييط، بنعيسى عسو، الخطاب الساني العربي، هندسة التواصل الإضماري: ج3، ص116.
[124] بل في كل حواريّاته ومواقفه.
[125] أزاييط، بنعيسى عسو، الخطاب اللساني العربي، هندسة التواصل الإضماري: ج3، ص116.
[126] أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين، مقتل الطالبيين: ص78، المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص51.
[127] آل عمران: آية110.
[128] يُنظر: أزاييط، بنعيسى عسو، الخطاب اللساني العربي، هندسة التواصل الإضماري: ج3، ص116.
[129] يُنظر: الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج5، ص402.
[130] يُنظر: الأنصاري، عبد الله بن هشام، مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب: ج1، ص188.
[131] يُنظر: السيّد خضر، أبحاث في النحو والدلالة: ص152.
[132] وهذا ما سيكتشفه القارئ في الفصل الرابع من الرسالة الذي سيتناول قاعدة الطريقة.
[133] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص52. البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الإمام الحسين×): ص295.
[134] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص52. البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين×): ص295.
[135]أزاييط، بنعيسى عسو، الخطاب اللساني العربي، هندسة التواصل الإضماري: ج3، ص114.
[136] يُنظر: المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص52.
[137] سيتّضح تفصيل ذلك في الفصل الثاني إن شاء الله.
[138] القيومي، جواد، صحيفة الحسين× (جمع): ص100. الريشهري، محمد، أهل البيت^ في الكتاب والسنّة: ص290. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص82.
[139] هكذا وردت والصحيح لمَ لمْ تقتله.
[140] يُنظر: القيومي، جواد، صحيفة الحسين (جمع): ص100. الريشهري، محمد، أهل البيت^ في الكتاب والسنّة،: ص290. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص82.
[141] سيأتي ذكره في المبحث الثاني.
[142] فقد ورد عن صاحب المناقب والسيِّد ابن طاووس: حتّى أصابته اثنتان وسبعون جراحة، وقال ابن شهر آشوب: قال أبو مخنف: عن جعفر بن محمّد بن علي×، قال: وجدنا بالحسين ثلاثاً وثلاثين طعنة وأربعاً وثلاثين ضربة، وقال الباقر×: أصيب الحسين×، ووجد به ثلاثمائة وبضعة وعشرون طعنة برمح، وضربة بسيف، أو رمية بسهم، وروي: ثلاثمائة وستون جراحة، وقيل: ثلاث وثلاثون ضربة سوى السهام، وقيل: ألف وتسعمائة جراحة، وكانت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفذ، وروي أنّها كانت كلّها في مقدّمه×. يُنظر: اين طاووس، علي بن موسى، اللهوف: ص 71، والصدوق، محمّد بن علي، الأمالي: ج1، ص228، وابن شهر آشوب، محمّد بن علي، مناقب آل ابي طالب: ج3، ص114و ص258.
[143] القيومي، جواد، صحيفة الحسين× (جمع): ص100. الريشهري، محمد، أهل البيت^ في الكتاب والسنّة: ص290. ويُنظر: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص82.
[144] يُنظر: المصدر نفسه. وفي بعض الروايات: (أريحوا الرجل). يُنظر: الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي: ص226، المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص322، البحراني، عبد الله، العوالم (الإمام الحسين×): ص171.
[145] نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات: ص234.
[146] يُنظر: السيّد خضر، أبحاث في النحو والدلالة: ص136.
[147] الجاحظ، عمر بن بحر، البيان والتبيين: ص1، ج78.
[148] العلوي، محمّد بن عقيل، النصائح الكافية: ص114، يُنظر: الأميني، عبد الحسين أحمد، الغدير في الكتاب والسنّة والأدب: ج4، ص26.
[149] يُنظر: أزاييط، بنعيسى، المعنى المضمر في الخطاب اللّغوي العربي والقيمة التنجيزية، مقاربة تداولية لسانية: ص495 ـ 498.
[150] يُنظر: كلام الإمام الحسين× مقاربة تداولية: ص48.
[151] القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص82.
[152] أي: داروا وأصبحوا حلقة كبيرة.
[153] القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص82.
[154] المصدر نفسه: ج3، ص82.
[155] يُنظر: المتوكل، أحمد، الوظائف التداولية في اللغة العربية: ص161.
[156] يُنظر: الصبان، محمّد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: ج3، ص197.
[157] يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص197.
[158] الحباشة، صابر، مغامرة النص من النحو إلى التداولية، قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني: ص103.
[159] ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص: ج1، ص247.
[160] يُنظر: الاسترابادي، رضي الدين، شرح الرضي على الكافية: ج1، ص407.
[161] يُنظر: المصدر نفسه، ص374. ويُنظر: الخضري، محمّد بن مصطفى، حاشية الخضري على ابن عقيل: ج2، ص71.
[162] ابن المبارك، عبد الله، مسند ابن المبارك: ص65.
[163] يُنظر: شروح التلخيص، سعد الدين التفتزاني: ج1، ص302، الدسوقي، محمّد عرفة، حاشية الدسوقي: ص313.
[164] الحباشة، صابر، مغامرة النص من النحو إلى التداولية، قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني: ص101.
[165] تقتضي العادة أن من يرتكب جريمة قتل يخفي اسمه.
([166]] الأعراف: آية92.
[167] يُنظر: الحباشة، صابر، مغامرة النص من النحو إلى التداولية، قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني: 101 ـ 102.
[168] القيومي، جواد، صحيفة الحسين× (جمع): ص100. الريشهري، محمد، أهل البيت^ في الكتاب والسنّة: ص290. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص82.
[169] قصدي من القوة الإنجازية: هي الشدّة والضعف اللذان يمكن أن يعرض بأحدهما غرض أنجازي واحد في سياق بعينه من سياقات استعمال المنطوق، وهي بالتالي خاصّية المنطوقات دون الجمل، فالمنطوق الواحد يمكن أن يمتلك قوى أنجازية مختلفة في سياقات استعمال متعدّدة.
يُنظر: بحث منال النجار في كتاب التداوليات علم استعمال اللغة، إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي: ص314.
[170] Holmes، janet، modifying op، cit، p: 348.
نقلاً عن: بحث منال النجار في كتاب التداوليات علم أستعمال اللغة، إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي: ص326.
[171] الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج1، ص62. السند، محمد، الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد: ص373.
[172] يُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): ج4، ص1477.
[173] يُنظر: ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج10، ص105 ـ 106.
[174] الحج: آية46.
[175] الحلي، ابن نما، مثير الأحزان: ص57. موسوعة كلمات الإمام الحسين×، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×: ص619. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ص610.
[176] الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص220. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص129.
[177] في هذه المحاورة حصل أكثر من خرق، وسيتبين بحث المقاصد التي حصلت بسبب تلك القواعد، سواء في احترامها أم في خرقها، وكل في فصله ومكانه، مثلاً: خرق قاعدة الكيف في المبحث الثاني من الفصل الثاني، وهكذا باقي القواعد.
[178] المفيد، محمّد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص67. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص77، الخوارزمي، الموفق بن أحمد المكّي، مقتل الحسين: ج1، ص223، والطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج5، ص386، باختلاف يسير، ومختصراً في: ابن شهرآشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص95، ونقله العلّامة المجلسي، محمّد باقر، في البحار الأنوار: ج44، ص365.
[179] الترس: هو نوع من الأسلحة المُتوقّى بها، والجمع أتراس، وتراس، وترسه، والترس: خشبة توضع خلف الباب يضبب بها السرير. يُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج6، ص32.
[180]آن ريبول، وجاك موشلر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ترجمة د. سيف الدين دغفوس، د. محمّد الشيباني، مراجعة د. لطيق زيتوني: ص19. يُنظر: كلام الإمام الحسين مقاربة تداولية: ص58.
[181] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص157.
[182] رسم الإمام عليٌ× ملامح هذه الصورة التفصيلية من قبل في خطبة يذكّر فيها النّاس بالموت، وهو: (فكفى واعظاً بموتى عاينتموهم، حمُلوا إلى قبورهم غير راكبين، وأُنزلوا فيها غير نازلين، فكأنّهم لم يكونوا للدنيا عمّاراً، وكأنّ الآخرة لم تزل لهم داراً). يُنظر: نهج البلاغة، خطب الإمام علي×، تحقيق وشرح: الشيخ محمّد عبده: ج2، ص128.
[183] يُنظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص99 ـ 100، والخليفة، هاشم عبد الله، نظرية التلويح الحواري: ص29.
[184] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد المكّي، مقتل الحسين×: ج1، ص188. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ص44، ص329. المهتدي البحراني، عبد العظيم، من أخلاق الإمام الحسين×: ص164. مع اختلاف في العبارة.
[185] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص 37، القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص59.
[186] من قبيل: أنّ الإمام× عرّض نفسه وأهل بيته من النساء والأطفال للتهلكة، والتهمة الأخرى التي راح بعض مرضى النفوس يتصيّدونها، مستدلّين بقوله× (شاء الله أن يراني قتيلاً، وأن يراهن سبايا) هي: إذا كانت إرادة الله حاصلة وماضية في خلقه، فأي فضيلة ـ لا سمح الله ـ لقيام الأمام الحسين×بوجه الظلم والطغيان وتغيير السنّة والعبث بالشريعة السمحاء؟ إذا كانت سنن الله ماضية في خلقه فلم نسُبّ يزيداً؟ وبالتالي كيف يحاسب الله يزيداً على أمر قد أُجْبِرَ عليه؟ ولِمَ نقول الحسين× ظُلم؟ وفي الردّ على هذه الشبهة نقول انّ الإرادة والمشيئة التي قصدها الإمام× ليست إرادة ومشيئة تكوينيّة، بحيث تكون ماضية ويكون الفرد حيالها مجبراً، فالأمر عندهم^ (لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين)، ومن هنا يكون قصده× بالإرادة والمشيئة هو الإرادة التشريعية التي من قبيل فرض الأحكام والتكاليف الشرعية (كالصلاة والصوم) التي اقتضت المشيئة الإلهية الالتزام بها وتطبيقها لكن لا على نحو الجبر والإكراه (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ).
[187] يُنظر: الخليفة، هاشم عبد الله، نظرية التلويح الحواري: ص33.
[188] يُنظر المصدر نفسه: ص45.
[189] يونس: آية71.
[190] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص322. أبو مخنف الأزدي، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص116. العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص96. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص188.
[191] وممّا يؤيّد صحّة هذا المعنى الظروف التي اكتنفت الخطاب ـ كما نقلها الطبري ـ منها: أنّ الحسين نادى بصوت عال...، وقول عمر ابن سعد، ومقاطعة الشمر للحسين... الخ. يُنظر: الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص323. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص61.
[192] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص6.
[193] المصدر السابق: ج44، ص329.
[194] يُنظر: الفوزان، عبد الله بن صالح، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك: ج3، ص44.
[195] المرادي، الحسن بن قاسم، الجنى الداني في حروف المعاني: ص367.
[196] يُنظر: الصعيدي، عبد المتعال، البلاغة العالية (علم المعاني): ص100 ـ 101.
[197] يُنظر: الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج1، ص348.
[198] يُنظر: البروجردي، حسين، جامع أحاديث الشيعة: ج15، ص409، ويُنظر: السبحاني، جعفر، الحديث النبوي بين الرواية والدراية: ص163.
[199] عدّ من المستشهدين بين يدي الإمام الحسين×، وقد وقع التسليم عليه في زيارتي الناحية والرجبية. يُنظر: الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج5، ص214.
[200] السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص153. والأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج4، ص568.
[201] أنواع الدلالة: مطابقية (معجمية)، تضمّنية، التزامية.
[202] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، صور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد: ج1، ص79.
[203] يُنظر المصدر نفسه.
[204] يُنظر: الخليفة، هاشم عبد الله، نظرية التلويح الحواري: ص45.
[205] يُنظر: الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري ج5، ص402.
[206] السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص32، المرعشي النجفي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج11، ص613. الدمشقي الباعوني، محمّد بن أحمد، جواهر المطالب في مناقب الإمام علي×: ص284.
[207] يُنظر: الراغب الأصفهاني، الحسين، مفردات ألفاظ القرآن: ص358.
[208] الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج2، ص71 ـ 72.
[209] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج3، ص304.
[210] ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر، بلاغات النساء: ص23. صفوت، أحمد زكي، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة: ج3، ص139.
[211] آل عمران: آية178.
[212] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج7، ص139. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص403.
[213] ومن أشهرهم أبي العباس المبرّد (293 أو 285هـ) بقوله: (واعلم أنّ الطلب من النهي بمنزلته من الأمر، يجري على لفظه كما يجري على لفظ الأمر) المبرّد، محمّد بن يزيد، المقتضب: ج2، ص135، وللنهي صيغة أصليّة كما للأمر صيغة أصلية، وهي (لا) الناهية الجازمة؛ إذ (للنهي حرف واحد وهو لا الجازمة في قولك لا تفعل، والنهي محذو به حذو الأمر في أنّ أصل استعمال (لا تفعل) أن يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادف ذلك أفاد الوجوب، وإلّا أفاد طلب الترك فحسب...، والأمر والنهي حقّهما الفور) السكاكي، يوسف بن محمد، مفتاح العلوم: ص320.
إذن هو طلب الكفّ عن فعل شيء على وجه الاستعلاء والإلزام، ولا يأتي إلّا بهيأة المضارع المقترن بلا الناهية، وقد أجادت السيّدة× استعماله في مقصديّة التوجيه، حيث استلزم معنى التحقير والإهانة، والذي هيأ المتلقّي لفهم هذا المعنى المستلزم هو تضافر سياق الكلام مع القرائن الحالية والمقامية، فضلاً عن توخّي السيدة زينب × إختيار الألفاظ الواضحة التي جاءت مفعمة بروح الأمان وصدق الاعتقاد.
[214] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص35.
[215][215] غطرس، الغطرسة: الإعجاب بالنفس، والتطاول على الأقران. يُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج4، ص462 ـ 463.
[216] الحاج، ذهبيّة حمو، التحليل التداولي للخطاب السياسي: ص239.
[217] يُنظر: فرانثيسكو يوس راموس، مدخل إلى دراسة التداولية، مبدأ الملاءمة والتاويل، ترجمة وتقديم: يحيى حمدان: ص100.
[218] يُنظر: عمّار حسن عبد الزهرة، أدعية الصحيفة السجّاديّة دراسة تداولية: ص73 ـ 74.
[219] جان كوهين، بنية اللُّغة الشعريّة، ترجمة: عبد الولي ومحمّد العمري: ص23.
[220] يُنظر: القيرواني الأزدي، أبو الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج1، ص268. ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ج2، ص71.
[[221]][221]القيرواني الأزدي، أبو الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج1، ص268.
[222] وهو أوّل خطاب له× في أصحابه قبل انطلاق المسيرة.
[223] الحلي، ابن نما، مثير الأحزان: ص29. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص366. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص70. الحلواني، الحسين بن محمد، نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ص86.
[224] يُنظر: هادي سعدون هنون، التصوير الفنّي في خطب المسيرة الحسينية: ص95.
[225] يُنظر: هادي، سعدون هنون، التصوير الفني في خطب المسيرة الحسينية: ص96.
[226] يُنظر: السكاكي، يوسف بن محمد، مفتاح العلوم: ص464.
[227] المائدة: آية106.
[228] الصدر، محمد، منبر الصدر: ص37.
[229] يُنظر: الصدر، محمد، منبر الصدر: ص37.
[230] الزمر: آية30.
[231]يُنظر: الصدوق، محمّد بن علي، عيون أخبار الرضا×: ج2، ص261، حديث: 39.
[232]يُنظر: الصدر، محمد، منبر الصدر: ص37.
[233]يُنظر: السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الإمام الحسين×: 42، و21.
[234] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص214 ـ 215.
[235] خفق: نام نومة خفيفة. وعنّ: ظهر أمامه.
[236] المفيد، محمّد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص82.
[237] يُنظر: الصدر، محمد، منبر الصدر: ص32 ـ 62.
[238] يوسف: آية84.
[239] يُنظر: المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص328.
[240] يُنظر: ابن شهرآشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص224.
[241] يُنظر، ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص152.
[242] يُنظر: البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص67.
[243] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص24. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص131. العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص313.
[244] المفيد، محمّد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص81. الريشهري، محمد، الصحيح من مقتل سيّد الشهداء وأصحابه^: ج1، ص669.
[245] موسوعة شهادة المعصومين^، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×: ج2، ص153.
[246] فقد روي عن الإمام الصادق×: (لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين)، يُنظر: الصدوق، محمّد بن علي، الهداية: ص 18.
[247] يُنظر: الشريف الرضي، محمّد بن الحسين، خصائص الأئمة^: ص 63.
[248] يُنظر: الجرجاني، عبد القاهر، المقتصد في شرح الإيضاح: ج1، ص508 ـ 509.
[249] يُنظر: الإسترابادي، رضي الدين، شرح الكافية: ج3، ص331.
[250] يُنظر: المخزومي، مهدي، في النحو العربي نقد وتوجيه: ص45 ـ 46.
[251] يُنظر: النحوي البغدادي، أحمد بن الحسن بن شقير، الجمل في النحو: ص228.
[252] يُنظر: الصفار، حسن بن موسى، عاشوراء ثقافة النهضة والبناء: ص195.
[253] الحلّي، ابن نما، مثير الأحزان: ص29. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص367.
[254] يُنظر: تمام حسّان، اللغة العربية معناها ومبناها: ص251.
[255] الاستلزام هنا من الاستلزام اللّغوي العام الذي مرّ ذكره في التمهيد.
[256] يُنظر: التمهيد من هذه الرسالة.
[257]يُنظر: ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج11، ص50 (بذل).
[258]يُنظر: الآصفي، محمّد مهدي، في رحاب عاشوراء: ج3، ص298.
[259]ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج2، ص370 (مهج).
[260] هذا ما سيتطرّق إليه البحث في الفصل الرابع (قاعدة الطريقة).
[261] يُنظر: الآصفي، محمّد مهدي، في رحاب عاشوراء: ج3، ص293.
[262] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص332.
[263] العنكبوت: آية69.
[264] الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج16، ص151.
[265] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج24، ص143.
[266] ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج13، ص451 (وطن).
[267] الآصفي، محمّد مهدي، في رحاب عاشوراء: ج3، ص294.
[268] يُنظر: المطهري، مرتضى، الملحمة الحسينية: ج2، ص96.
[269] يُنظر: الصدر، محمد، أضواء على ثورة الحسين×: ص113.
[270]هو انتفاءالجزاء بانتفاء الفعل في الجملة الشرطية. يُنظر: الصدر، محمّد باقر، دروس في علم الأصول: ج1، ص222.
[271]وهو ما عليه التداوليون اليوم وغرايس في استلزامه الحواري.
[272] الجاحظ، عمر بن بحر، البيان والتبيين: ج1، ص153.
[273] الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة: ص30.
[274] يُنظر: الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ص 67.
[275] السكاكي، يوسف بن محمد، مفتاح العلوم: ص369.
[276] يُنظر: الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ص67.
[277] يُنظر: ابن الأثير، ضياء الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ج2، ص73 ـ 74.
[278] محمّد مفتاح، ديناميّة النصّ، تنظير وإيجاز: ص57.
[279] يُنظر: أياد عبد الودود، التصوير المجازي: ص67.
[280] ابن طاووس، علي بن موسى، الملهوف في قتلى الطفوف: ص126.
[281] عبد الفتّاح لاشين، البيان في ضوء أساليب القرآن: ص193.
[282] الصاوي، أحمد، فن الاستعارة: ص306.
[283] يُنظر: ميثم قيس مطلك، نثر الإمام الحسين×: ص32.
[284] السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص43.
[285] الأسس النفسية: ص224.
[286] المصدر نفسه: ص224.
[287] يُنظر: ميثم قيس مطلك، نثر الإمام الحسين×: ص33.
[288] أنطوان بارا، الحسين في الفكر المسيحي: ص121.
[289] يُنظر: الوائلي، إسماعيل، دستور الصدر: ص83.
[290] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص125.
[291] المصدر نفسه: ج2، ص126.
[292] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص126.
[293] ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر، بلاغات النساء: ص22، نثر الدّر: ص18.
[294] يُنظر: الموسوي، زينب عبد الله كاظم، خطب سيّدات البيت العلوي حتى نهاية القرن الأول الهجري (دراسة موضوعية فنّية): ص162.
[295] ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر، بلاغات النساء: ص35 ـ 36، ويُنظر: الخوارزمي، الموفّق بن أحمد المكّي، مقتل الحسين×: ج2، ص71 ـ 74، ويُنظر: الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص32 ـ 34.
[296] يُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): ج3، ص1186.
[297] يُنظر: الأفعال لابن القوطية: ص58.
[298] حسين عمران محمد، شعر أبي نواس دراسة تداولية: ص265.
[299] مغنية، محمّد جواد، في ظلال نهج البلاغة، محمّد جواد مغنية: ج4، ص374.
[300] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج5، ص403. ويُنظر: الريشهري، محمد، الصحيح من مقتل سيّد الشهداء وأصحابه^: ج1، ص675.
[301] الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج7، ص90.
[302] أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة: ج2، ص151.
[303] الخوارزمي، الموفّق بن أحمد المكّي، مقتل الحسين×: ج1، ص357 ـ 358. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص5.
[304] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ج94.
[305] فمسَحَ عنه الرُّحَضاءَ؛ هو عرَق يغسل الجلد، وكثيراً ما يستعمل في عرَق الحُمّى والمرض. والرُّحَضاءُ: العرَقُ في أَثَر الحُمّى. والرحضاء: الحُمّى بعرق. ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج7، ص 154.
[306] الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ص430.
[307] الاسترابادي، رضي الدين، شرح الكافية: ج3، ص150.
[308] الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ص 66.
[309] يُنظر: المصدر نفسه: ج3، ص150.
[310] الثعالبي النيسابوري، عبد الملك، فقه اللغة وسرّ العربية: ص293.
[311] ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر، بلاغات النساء: ص24، نثر الدر: ص20، الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص111.
[312] يُنظر: الموسوي، زينب عبد الله كاظم، خطب سيّدات البيت العلوي حتى نهاية القرن الأول الهجري: ص45.
[313] الجاحظ، عمر بن بحر، البيان والتبيين: ص61.
[314]] ) المؤمنون: آية12.
[315] الراغب الأصفهاني، الحسين، مفردات ألفاظ القرآن: ص418.
[316] يُنظر: أثر كربلاء في خطابة آل البيت والتوّابين، رؤية عناصر الواقعة واللُّغة الفنّيّة (بحث منشور في مجلّة المنهاج) العدد: 5 ـ 6، السنة الثانية.
[317] الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج7، ص139. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص403.
[318] ابن هشام الحميري، عبد الملك، السيرة النبوية: ج4، ص41. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج21، ص106.
[319] يُنظر: المعلّم، محسن، زينب والظالمون: ص117 ـ 118.
[320] يُنظر: الخليفة، هاشم عبد الله، نظرية التلويح الحواري: ص85 ـ 107.
[321] يُنظر: التفتازاني، سعد الدين، مختصر المعاني: ص 265.
[322] محمّد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية: ص254.
[323] يُنظر: فاخوري، عادل، محاضرات في فلسفة اللغة: ص28.
[324] الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأُموي (ت 64 ه ـ 684 م): أمير، من رجالات بني أميّة، ولي المدينة (سنة57 ه) في أيام معاوية. ومات معاوية، فكتب إليه يزيد أن يأخذ له بيعة الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وكانا في المدينة، فطلبهما إليه ليلاً، قبل أن يشيع موت معاوية، فأخبرهما بما جاءه من يزيد، فاستمهلاه إلى الصباح، وقالا: نصبح، ويجتمع الناس ـ للبيعة – فنكون منهم. وانصرفا. وكان في المجلس مروان بن الحكم، فلام الوليد على تركهما يخرجان قبل المبايعة، وقال: إنّك لن تراهما! فقال الوليد: إنّي لأعلم ما تريد! وما كنت لأسفك دماءهما ولا لأقطع أرحامهما. وعزله يزيد (سنة 60) واستقدمه إليه. فكان من رجال مشورته بدمشق، ثم أعاده (سنة 61) وثورة عبد الله بن الزبير، في إبّانها بمكة. قال ابن الأثير: " ثمّ أنّ ابن الزبير عمل بالمكر في أمر الوليد، فكتب ليزيد: إنّك بعثت إلينا رجلاً أخرق، ولو بعثت رجلاً سهل الخلق رجوت أن يسهل من الأمور ما استوعر، وأن يجتمع ما تفرّق، فعزل يزيد الوليد، وولى عثمان بن محمّد بن أبي سفيان، وهو فتى غر حدث " وظل الوليد في المدينة، وحجّ بالناس سنة 62، وتوفّي بالطاعون. راجع: الزركلي، خير الدين، الأعلام: ج8، ص121.
[325] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص13. الموفق بن أحمد المكّي، مقتل الحسين×: ج1، ص183.
[326] مروان شخصيّة مجهولة النسب، فلا يعرف له أب، وإنّما نُسب للحكم بن ابي العاص بن أميّة بن عبد شمس، الذي أسلم يوم الفتح، وكان يتجسّس على رسول الله’، وينقل أخباره إلى الكفّار، وقيل: ما أسلم إلّا لهذا الغرض، ولم يحسن إسلامه، نفاه النبي’ إلى الطائف، ولعنه. قال الأصمعي: أما قول الحسين: ( يا ابن الداعية إلى نفسها ) فذكر ابن إسحاق أنّ أم مروان اسمها أمية أو سمية، وكانت من البغايا في الجاهلية، وكان لها راية مثل راية البيطار، هذه هي أسرة مروان، وهذا شرفها الذي عرفت به، وكانت تسمّى أم حبتل الزرقاء، يُنظر: المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، هامش 109. الحارثي، جعفر عباس، بلاغة الإمام الحسين×: ج2، ص48 ـ 49.
[327] ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التأريخ: ج3، ص264.
[328] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص549. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التأريخ: ج3، ص264.
[329] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص549.
[330] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص14. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص10. المرعشي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج33، ص615. مع اختلاف في بعض العبارات.
[331] حرص البحث على تناول الحواريّة بتفاصيلها.
[332] المفيد، محمّد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص34. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج3، ص264. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص25. القرشي، باقر شريف، حياة الإمام الحسين×: ج2، ص256. مع اختلاف في الألفاظ في بعض المصادر.
[333] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص549.
[334] هنا الخرق جاء على وفق قواعد التأدّب التي اعتمدتها روبين لاكوف، والتي سبق أن أشار إليها غرايس إشارة عابرة.
[335] وسيظهر القصد نفسه عبر خرق قاعدة الطريقة في خرق توالي الملفوظات في تغيير رتبة الفاعل.
[336] يُنظر: بحث منال النجار في كتاب التداوليات علم استعمال اللغة، إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي: ص322.
[337] يُنظر: المصدر نفسه: ص322.
[338] يُنظر: السكاكي، يوسف بن محمد، مفتاح العلوم: ص71. الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ص261.
[339] يُنظر: محمّد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبية: ص62
[340] القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودة لذوي القربى: ج3، ص67. وقد أورده أيضا أبو مخنف، إلا أنه بدل (شارب المنون) ذكر (وارد المنون)، مقتل الحسين×: ص179
[341] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج3، ص68. وجدته غير موزون والصحيح (إنّي أحامي أبداً عن ديني) وهو من بحر الرجز.
[342] ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص182 ـ 183.
[343] القطاء: جمع قطاة، وهي طائر بحجم الحمام، صوته قطا قطا، وهذا مثل، قال الميداني: نزل عمرو بن أمامة على قوم من مراد، فطرقوه ليلاً، فأثاروا القطا من أماكنها، فرأتها أمرأته طائرة، فنبّهت المرأة زوجها، فقال: إنّما هي القطا، فقالت: لوترك القطا ليلاً لنام. يضرب لمن حمل على مكروه من غير إرادته، وقيل غير ذلك. يُنظر: النيسابوري الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد، مجمع الأمثال: ج2، ص174، رقم المثل: 3231.
[344] ولا يرى المجلسي لذكر الاغتصاب وجهاً، فيقول: والظاهر أنّه تصحيف؛ والصحيح: (أفتحتسب نفسك احتساباً). يقال: احتسب ولداً له: إذا مات ولده كبيراً، ومثله: احتسب نفسه: إذا عدّها شهيداً في ذات الله، وقد مرّ في (ص138 من ج44) كلام الحسن بن علي÷: (اللهم إنّي أحتسب نفسي عندك ) يُنظر: المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص3 في الهامش.
[345] موسوعة كلمات الإمام الحسين×، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×: ص490.
[346] سيأتي بيان هذه القاعدة تفصيلا في الفصل الرابع من الرسالة.
[347] وذهب نفر من اللّغويين إلى أنّ التعزّى غير التصبّر؛ إذ المرء يعزّى لكي يصبر، بل بعضهم يفسّره بأحسن الصبر، وبالتالي يكون مراده ذهاب الصبر كلّه، أدناه وأعلاه، وأقلّه وأكثره. يُنظر: رجاء عيد، فلسفة البلاغة بين التقنية والتطوير: ص111.
[348] يُنظر: ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج5، ص374 مادة (عزز).
[349] ابن طاووس، علي بن موسى، اللّهوف في قتلى الطفوف: ص90، الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص28.
[350]عبد العزيز عتيق، علم المعاني، عبد العزيز عتيق: ص81.
[351] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص98. الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص108.
[352] يُنظر: السيّد خضر، أبحاث في النحو والدلالة: ص173.
[353] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص94 ـ 95. الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص110ـ 112.
[354] حسن محمّد وجيه، مقدمة في علم التفاوض السياسي والاجتماعي: ص74.
[355] يُنظر: الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج1، ص348.
[356] فودة عبد العليم السيد، أساليب الاستفهام في القرآن الكريم: ص292.
[357] عبد العزيز عتيق، علم المعاني: 96. علي الجارم ومصطفى أمين، جواهر البلاغة: ص85.
[358] ابن طاووس، علي بن موسى، اللّهوف في قتلى الطفوف: ص99.
[359] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص88. الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص307. العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص74.
[360] السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص114. المرعشي النجفي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج11، ص605.
[361] ابن حزم، علي بن أحمد، المحلّى: ج1، ص12. السبكي، علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي: ج2، ص562. المجلسي، محمّد تقي، روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه: ج5، ص366.
[362] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص88. الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ص4، ص306. العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص74.
[363] المصادر الثلاثة نفسها.
[364] يُنظر: الحاج، ذهبيّة حمو، التحليل التداولي للخطاب السياسي: ص454.
[365] يُنظر: المبرّد، محمّد بن يزيد، المقتضب: ج2، ص46.
[366] الوسائل اللّغوية للتأثير والإقناع في مقالات إحسان عبد القدوس عن الأسلحة الفاسدة، إيمان السعيد جلال، صحيفة اتلالسن (24)، 2008م: ص59.
[367] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص306. العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص74. أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص87.
[368] وجلين: خائفين، موجفين: مسرعين.
[369] ابن كثير الدمشقي، إسماعيل، البداية والنهاية: ج8، ص194. أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص118. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص102.
[370] الصدر، محمد، أضواء على ثورة الحسين×: ص97 ـ 100.
[371] يُنظر: المطهري، مرتضى، بين المنبر والنهضة الحسينية: ص179.
[372] الصدر، محمد، أضواء على ثورة الحسين×: ص101.
[373] روى الخوارزمي بإسناده عن زيد بن عليّ، وعن محمّد بن الحنفيّة؛ عن عليّ بن الحسين زين العابدين÷ أنّه قال: لمّا أتي برأس الحسين× إلى يزيد، كان يتّخذ مجالس الشّرب، ويأتي برأس الحسين فيضعه بين يديه ويشرب عليه، فحضر أحد مجالسه رسول ملك الرّوم، وكان من أشراف الرّوم وعظمائها. يُنظر: موسوعة شهادة المعصومين^، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×: ج2، ص382 ـ 383.
[374] هكذا ورد، والصحيح (ما ديني إلّا أحسن من دينك)
[375] فقال: إنّ بين عمان والصّين بحراً مسيرته سنة، ليس فيه عمران إلّا بلدة واحدة في وسط الماء، طولها ثمانون فرسخاً، وعرضها كذلك، وما على وجه الأرض بلدة أكبر منها، ومنها يحمل الكافور والياقوت والعنبر، وأشجارهم العود، وهي في أيدي النّصارى، لا ملك لأحد فيها من الملوك، وفي تلك البلدة كنائس كثيرة، أعظمها كنيسة الحافر، في محرابها حُقّة من ذهب معلّقة فيها حافر، يقولون: إنّه حافر حمار كان يركبه عيسى، وقد زيّنت حوالي الحُقّة بالذّهب والجواهر والدّيباج والإبرسيم، وفي كلّ عام يقصدها عالم من النّصارى، فيطوفون حول الحُقّة ويزورونها ويقبّلونها، ويرفعون حوائجهم إلى الله ببركتها، هذا شأنهم ودأبهم بحافر حمار يزعمون أنّه حافر حمار كان يركبه عيسى نبيّهم؛ وأنتم تقتلون ابن بنت نبيّكم، لا بارك الله فيكم ولا في دينكم.
[376] يُنظر: القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ص29. الحسيني الفيروزايادي، مرتضى، فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج3، ص298. موسوعة شهادة المعصومين^، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×: ج2، ص382 ـ 383.
[377] كان يزيد يتّخذ مجالس الشّرب، ويأتي برأس الحسين، فيضعه بين يديه ويشرب عليه.
[378] يُنظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيات الخطاب: ص261 ـ 262.
[379] يُنظر: المصدر نفسه: ص445 ـ 447.
[380] يُنظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيات الخطاب: ص284.
[381] هدى عبد الغني باز، الخطاب السياسي عند مصطفى كامل: ص99.
[382] يُنظر: الصراف، علي محمّد حجي، الأفعال النجازية في العربية المعاصرة: ص127.
[383][383] المصدر نفسه: ص136.
[384] سنأتي على التفصيل في ذلك ضمن الفصل الرابع لهذه الرسالة.
[385] عبد الحكيم سليمان وادي، بحث وظائف البعثات الدبلوماسية، المبحث الثاني، الوظيفة الدبلوماسية: https.ll Pulpit. Alwatanvoice. Com\Articles\2013\03\15\288371. Html.
[386] الشهري، عبد الهادي ظافر، استراتيجيات الخطاب: ص456.
[387] يُنظر: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها، نقلاً عن الدكتور عصام العماد، 9، محرّم الحرام، 1439هـ، قناة الفرات الفضائية.
[388] يُنظر: دان سبيربر وديدري ولسون، نظرية الصلة أو المناسبة في التواصل الإدراكي، ترجمة: هاشم عبد الله الخليفة: ص281.
[389] العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص100.
[390] يُنظر: دان سبيربر وديدري ولسون، نظرية الصلة أو المناسبة في التواصل الإدراكي، ترجمة: هاشم عبد الله الخليفة: ص281.
[391]فرانثيسكو يوس راموس، مدخل إلى الدراسة التداولية، مبدأ التعاون ونظرية الملائمة والتأويل، ترجمة وتقديم: يحيى حمدان: ص93.
[392] برير بن خضير الهمداني المشرقي (وبنو مشرق بطن من همدان) كان برير شيخاً تابعيّاً ناسكاً، قارئاً للقرآن، من شيوخ القرّاء، ومن أصحاب أمير المؤمنين×، وكان من أشراف أهل الكوفة من الهمدانيين، وهو خال أبي إسحاق الهمداني السبعي. السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص121.
[393] هو عبد الرحمن بن عبد ربّه الأنصاري الخزرجي، رجل صحابي أدرك النبي’، وشهد الغدير ومن رواة حديثه، وكان من أصحاب الإمام علي× ومن جملة الشهود الذين شهدوا له وقاموا تأييداً لولاية علي× في يوم رحبة، وورد عن الأصبغ بن نباتة، قال: نشد علي الناس في الرحبة، من سمع النبي’ يوم غدير خم ما قال، إلّا قام، ولا يقوم إلّا من سمع رسول الله’ يقول، فقام بضعة عشر رجلاً فيهم أبو أيّوب الأنصاري وأبو عمرة بن عمرو بن محصن وأبو زينب وسهل بن حنيف وخزيمة بن ثابت وعبد الله بن ثابت الأنصاري وحبشي بن جنادة السلولي وعبيد بن عازب الأنصاري والنعمان بن عجلان الأنصاري وثابت بن وديعة الأنصاري وأبو فضالة الأنصاري وعبد الرحمن بن عبد رب الأنصاري، فقالوا: نشهد أنّا سمعنا رسول الله’ يقول: ألا إنّ اللهوليّي وأنا ولى المؤمنين، ألا فمن كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وأحبّ من أحبّه، وأبغض من أبغضه، وأعن من أعانه. استشهد في يوم عاشوراء مع الحسين×. يُنظر: ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، الإصابة: ج4، ص266 ـ 277. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، أسد الغابة: ج3، ص307. السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ج116 ـ 117.
[394] النورة: مادة ـ كانت ولا زالت ـ لإزالة شعر الجسم كالإبطين...، وهي كالتراب إذا مزجت بالماء يطلى بها الموضع فيترك فترة ثم تزال.
[395] الطلاء هو وضع النورة على الشعر الذي يراد إزالته، كما يقال طليت الجدار، أي: صبغته.
[396] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص58. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص245. مع اختلاف في بعض العبارات.
[397] الجاحظ، عمر بن بحر، البيان والتبيين: ج1، ص76.
[398] إدريس سرحان، طرق التضمين الدلالي والتداولي في اللغة العربية وآليات الاستدلال: ص109. ويُنظر: نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات: ص234.
[399] يُنظر: التداولية في البحث اللّغوي النقدي، تحرير د. بشرى البستاني: ص14 ـ 15.
[400] زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن الخزرج الأنصاري، أبو عمرو، من أصحاب رسول الله’ والإمام أمير المؤمنين والحسن والحسين^، كانت له مع النبي’ سبع عشرة غزوة، روى عن النبي’ وأمير المؤمنين×، وروى عنه أنس بن مالك وأبو الطفيل والنهدي وغيرهم، مات سنة 65، وقيل غير ذلك. الطوسي، محمّد بن الحسن، رجال الشيخ الطوسي: 20، 41، 68، 73. اليافعي اليمني، عبد الله بن أسعد، مرآة الجنان: ج1، ص141. ابن العماد الحنبلي، عبد الحي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ج1، ص74. ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، تهذيب التهذيب: ج3، ص394، المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال: ج1، ص461.
[401] الكهف: آية9.
[402] الكوفي، محمّد بن سليمان، مناقب الإمام أمير المؤمنين×: ج2، ص267. المفيد، محمّد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص117. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص188، 121. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص389، 412. ابن حمزة الطوسي، محمّد بن علي، الثاقب في المناقب: ص333. قطب الدين الراوندي، سعيد بن عبد الله، الخرائج والجرائح: ج2، ص577.
[403] يس: آية65.
[404] الصدوق، محمّد بن علي، الهداية: ص163.
[405] يُنظر: الصدر، محمد، أضواء على ثورة الإمام الحسين×: ص223.
[406] لما حُمل الرأس الشريف ونُصب في مواضع الصيارفة حيث لغط المارّة وضوضاء المتعاملين، فأراد سيّد الشهداء توجيه النفوس نحوه؛ ليسمعوا عظاته، فتنحنح الرأس تنحنحاً عالياً، فاتجهت إليه الناس، واعتلتهم الدهشة حيث لم يسمعوا رأساً مقطوعاً يتنحنح قبل يوم الحسين.... يُنظر: أنطوان بارا، الحسين في الفكر المسيحي: ص115 – 116.
[407] وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ القاعدة الثالثة من قواعد مبدأ التعاون (الملائمة) حاضرةٌ في جميع القواعد وفي جميع المستويات (مستوى الاحترام، مستوى الخرق) فصاحب الخطاب رأى مناسبةً لخرق قاعدة الملائمة في الخطاب أعلاه.
[408] يُنظر: المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار ج45، ص121. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص389.
[409]يُنظر: المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار ج45، ص188. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص412. أنطوان بارا، الحسين في الفكر المسيحي: ص115 – 116.
[410] القصص: آية5.
[411] هذا طبعا على فرض أنّ خطاب الرأس الشريف حصل في الكوفة.
[412] يُنظر: الصدر، محمد، أضواء على ثورة الحسين×: ص223 ـ 224.
[413] السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص51.
[414] ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج5، ص340.
[415] يُنظر: الشهري، عبد الهادي بن ظافر، استراتيجيات الخطاب: ص346.
[416] القيومي، جواد، صحيفة الحسين×، (جمع): ص88. المرعشي النجفي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج27، ص206.
[417] استثمار الفرصة في هذا المشهد الحواري سواء كان للتزوّد من عبد الله الرضيع قبل الاستشهاد، أو لطلب الماء للرضيع. وعلى كلا التقديرين يكون صدور الفعل من الإمام الحسين×بدافع الرحمة والعطف التي تغمر وجوده القدسيّ.
[418] دلّت بعض القرائن التاريخية التي نقلتها بعض المصادر والمراجع، أنّ معسكر ابن سعد قد اختلفوا فيما بينهم، فقال بعضهم: (إن كان ذنبٌ للكبار فما ذنب الصغار) وقال آخرون: (لا تبقوا لأهل هذا البيت باقية) وكادت الفتنه أن تقع بينهم، فصاح ابن سعد في حرملة بن كاهل: (اقطع نزاع القوم) قال: فوضعت السهم في كبد القوس...، فرميته وهو في حجر أبيه، فذبحته من الوريد إلى الوريد، فتلقّى الحسين الدم بكفّه ورمى به نحو السماء). ابن شهرآشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص257. الحلّي، ابن نما، مثير الأحزان: ص52. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص49. الصدر، محمد، أضواء على ثورة الحسين×: ص217.
[419] الصدر، محمد، أضواء على ثورة الحسين×: ص237.
[420] يُنظر: المطهري، مرتضى، الملحمة الحسينية: ج3، ص346.
[421] ومن قبيل قول الإمام السجّاد×: أبالموت تخوّفني... فالموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. وقول على الأكبر: (إذاً ـ والله ـ لا نبالي.... الحرب بانت لها الحقائق...)، وقول القاسم: (الموت أحلى عندي من العسل)، وقول أبي الفضل العباس: (يانفس من بعد الحسين هوني...) وأقوال باقي الأصحاب كمسلم بن عوسجة وبشر بن عمرو الحضرمي وزهير... يُنظر: المطهري، مرتضى، الملحمة الحسينية: ج3، ص346.
[422] هنا حصل أمر خارق للعادة وهو عدم سقوط أيّة قطرة من الدم للأرض، وقد لوّح هذا الفعل إلى مقدار عظمة وقرب هذه الدماء ومقبوليّتها وعظمتها عند الله، وفيه إشارة إلى قوله تعالى(إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ).
[423] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص53. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الجسين×: ص296.
[424] يُنظر: الفصل الأول، ص 76.
[425] من الطبيعي أن تكون ردّة فعل المرأة التي تفقد أهل بيتها؛ الانكسار والبكاء والخيبة، لكن المفاجأة التي تراءت للسلطة الأمويّة بشكل عام، ولابن مرجانة بشكل خاص لم تكن بحسبان. وهذا معنى أن النهضة كانت حسينية الانطلاق زينبيّة البقاء.
[426] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص349. العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص150.
[427] آل عمران: آية157.
[428] البقرة: آية216.
[429] فيكفي ما ذكره يحيى المازني حيث قال: (كنت جوار أمير المؤمنين× مدّة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فوالله ما رأيت لها شخصاً، ولا سمعت لها صوتاً، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدّها رسول الله’ تخرج ليلاً، والحسن عن يمينها، والحسين عن شمالها، وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن مرّة عن ذلك، فقال: أخشى أن يُنظر أحد إلى شخص أختك زينب) البياتي، جعفر، الأخلاق الحسينية: ص 223.
[430] المحقق الحلّي، جعفر بن الحسن، المعتبر: ج1، ص307.
[431] العسكري، مرتضى، معالم المدرستين: ج3، ص22. الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير: ج23، ص289.
[432] المقرّم، عبد الرزاق، مقتل الحسين×: ص216 ـ 217. الفاضل الدربندي، أسرار الشهادة: ص387. النقدي، جعفر، الأنوار العلويّة: ص443.
[433] وهي معاهدة وقعت بين عامي 57 ـ 58هـ؛ وقعها معاوية بن أبي سفيان وقيصر الروم قسطنطين الرابع سنة 48 ـ 65هـ=668 ـ 685م.
[434] فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة: عبد القادر قنيني: ص79 ـ 80.
[435] يُنظر: المصدر نفسه: ص79 ـ 80.
[436] يُنظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص116.
[437] طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي: ص214.
[438] فالخطاب كما يقول الآمدي: (بأنّه اللفظ المتواضع عليه، المقصود به إفهام من هو متهيّء لفهمه) الآمدي، سيف الدين، الإحكام في أصول الأحكام: ج1، ص136.
[439] طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أوالتكوثر العقلي: ص225.
[440] المصدر نفسه: ص226.
[441] يُنظر: الباهي، حسن، الحوار ومنهجيّة التفكير النقدي: ص10.
[442] يُنظر: الباهي، حسن، الحوار ومنهجيّة التفكير النقدي: ص 10.
[443] يُنظر: الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظريّة وتطبيقيّة في البلاغة الجديدة، مجموعة مؤلفين، بإشراف: حافظ إسماعيلي علوي: ص70 ـ 78.
[444] يُنظر: صحراوي، مسعود، الأفعال الكلاميّة عند الأصوليين، دراسة في ضوء اللسانيّات التداوليّة، مجلّة اللغة العربية (مجلّة نصف سنوية)، عدد: 10، خريف 2014م: ص179.
[445]المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص340. الأمين، محسن، أعيان الشيعة: ج1، ص590. الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص565.
[446]يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، صور من تطبيقاتها، بهيكل جديد من طريف وتليد: ج1، ص42.
[447]الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): ص5، ص2016.
[448] الحجرات: آية11.
[449]الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): ج5، ص2016.
[450] البهبهاني، علي، مصباح الهداية في إثبات الولاية: ص81. الأنطاكي، محمّد مرعي، لماذا اخترت مذهب أهل البيت^: ص457.
[451]ابن شهرآشوب، محمّد بن علي، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص249، المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص5. الأمين، محسن، أعيان الشيعه: ج1، ص602.
[452] يُنظر: طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي: ص241.
[453] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص315. ابن الأثير، علي بن أبي الكرم، الكامل في التاريخ: ج4، ص56.
[454] يُنظر: خالد ميلاد، الإنشاء في العربية بين التراكيب والدلالة، دراسة نحوية تداولية: ص113.
[455]بحث منال النجار في كتاب التداوليات، علم استعمال اللغة، إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي: ص526.
[456] على أساس موقف المتكلّم من احترام القواعد أو خرقها.
[457] يُنظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص100.
[458] يُنظر: المصدر نفسه.
[459] يُنظر: المتوكل، أحمد، اللسانيات الوظيفيّة المقارنة، دراسة في التنميط والتطوير: ص81.
[460] يُنظر: العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص115.
[461] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص157، حديث: 20.
[462] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329.
[463] وهي ما كان الأمر موجّهاً للمتلقّي فعلاً لا قوّة.
[464] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص52.
[465] يوسف: آية65.
[466] الحجر: آية14.
[467] الأنعام: آية44.
[468] الراغب الأصفهاني، الحسين، مفردات ألفاظ القرآن: ص 621 ـ 622.
[469] الأعراف: آية96.
[470] يُنظر: الراغب الأصفهاني، الحسين، مفردات ألفاظ القرآن: ص621 ـ 622.
[471] يُنظر: السيوطي، جلال الدين، الدر المنثور: ج7، ص510.
[472] يُنظر: الآلوسي، محمد، روح المعاني: ج26، ص129.
[473] النصر: آية1، هذا وعد من الله تعالى لنبيّه’ وآله بالنصر بالفتح قبل وقوع الأمر، وقال الحسن ومجاهد: وعده الله فتح مكّة ونصرته على كفّار قريش. يُنظر: الطوسي، محمّد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج10، ص425. وورد في تفسيرها النعي لرسول الله’: (أما إنّ نفسي نعيت إليّ). يُنظر: القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير القمّي: ج2، ص446. الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان في تفسير القرآن: ج2، ص214.
[474] السجدة: آية29.
[475] يُنظر: الراغب الأصفهاني، الحسين، مفردات ألفاظ القرآن: ص621 ـ 622.
[476] كما هي الحال مع أخيه السيّد محمّد بن الحنفيّة (رضوان الله عليه).
[477] الفتح: آية1 ـ 2.
[478] أبو داوود السجستاني، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود: ج1، ص621.
[479] يُنظر: ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير: ج7، ص159.
[480] مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في كتاب الله المنزل: ج16، ص42.
[481] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص177.
[482] يُنظر: السند، محمد، الحداثة، العولمة، الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية: ص99.
[483] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد: ج2، ص446.
[484] يُنظر: بن قُرْقْمَاس، ناصر الدين محمد، زهر الربيع في شواهد البديع: ص 190.
[485] الحصري القيرواني، إبراهيم بن علي، زهر الآداب وثمر الألباب: ج1، ص100. أحمد زكي صفوت، جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة: ج2، ص51.
[486] الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج4، ص31، (السرعة) يُنظر: الراغب الأصفهاني، الحسين، مفردات ألفاظ القران: 845. الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): ج2، ص556 ـ 557، أهمد في السير: أسرع.
[487] الحارثي، جعفر عباس، بلاغة الإمام الحسين×: ص29 ـ 30.
[488] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد: ج2، ص447. عبد العزيز عتيق، علم البديع: ص135.
[489] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد: ج2، ص92.
[490] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد: ج2، ص72.
[491] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد: ج2، ص263.
[492] الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز: ص116.
[493] المصدر نفسه: ص116.
[494] سبأ: آية4.
[495] النجم: آية31.
[496] القلم: آية4.
[497] البقرة: آية197.
[498] البقرة: آية189.
[499] آل عمران: آية200.
[500] الطوسي، محمّد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن: ج2: ص143. الكاشاني، الملّا فتح الله، زبدة التفاسير: ج1، ص313.
[501] القمّي، علي بن إبراهيم، تفسير القمي: ج1، ص68.
[502] البقرة: آية189.
[503] سعد: هو سعد بن عبد الله الأشعري بن أبي خلف القمّي، عاصر الإمام الصادق×، وروى عنه، وكثيراً ما يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى، وكلاهما من أجلّة أصحابنا القمّيين. الخوئي، أبو القاسم، معجم رجال الحديث: ج9، ص 77.
[504] العياشي، محمّد بن مسعود، تفسير العياشي: ج1، ص86. هذا القصد المعنيّ بقوله’ (أنا مدينة العلم وعلي بابها) فمن أراد المدينة فليأتها من بابها؛ أي قصد الإلماح والإيماء. يُنظر البحراني، هاشم، البرهان في تفسير القرآن: ج1، ص409 وج4، ص73. الحويزي، عبد علي بن جمعة، تفسير نور الثقلين: ج1، ص177. المشهدي، محمّد بن محمّد رضا القمّي، تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب: ص260، الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القران: ج2، ص59.
[505] يُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج8، ص259 ـ 260. الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): ج2، ص588 ـ 589.
[506] ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص51.
[507] الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج5، ص199.
[508] الطباطبائي، محمّد حسين، الميزان في تفسير القران: ج2، ص57.
[509] مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في كتاب الله المنزل: ج2، ص14.
[510] العياشي أدراوي، الاستلزام الحواري في التداول اللساني: ص115.
[511] يُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية): ج2، ص172 ـ 173. الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج2، ص110.
[512] يُنظر: الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع: ص179.
[513] فتوح ابن أعثم، ج 5، ص 247 - 249، ومقتل الخوارزمي، ج2، ص 69-71
[514] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد من طريف وتليد: ج2، ص65 ـ 80.
[515] يُنظر: المصدر نفسه: ص66.
[516] التوبة: آية36.
[517] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد طريف وتليد: ص 66.
[518] يُنظر: المصدر نفسه: ص66.
[519] فقد مارست السلطة الأموية تضليلاً حتى أنّهم كانوا يجهلون حال الإمام علي× فيما إذا كان يصلّي أم لا؟. يُنظر: الأزدي، الفضل بن شاذان، الإيضاح: ص494، وهامشها.
[520] يُنظر: الميداني، عبد الرحمن حسن جنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها وصور من تطبيقاتها بهيكل جديد طريف وتليد: ج2، ص65 ـ 80.
[521] شروح التلخيص، سعد الدين التفتزاني: ج1، ص302، الدسوقي، محمّد عرفة، حاشية الدسوقي: ص313.
[522] الحباشة، صابر، مغامرة النص من النحو إلى التداولية، قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني: ص101.
[523] بدليل رواية صاحب المناقب (وقال صاحب المناقب وغيره: روي أنّ يزيد أمر بمنبر وخطيب ليخبر الناس بمساوئ الحسين وعلي÷ وما فعلا، فصعد الخطيب المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم أكثر الوقيعة في علي والحسين، وأطنب في تقريظ معاوية ويزيد، فذكرهما بكل جميل، قال: فصاح به علي بن الحسين: ويلك أيّها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوّأ مقعدك من النار، ثم قال علي بن الحسين÷: يا يزيد، إئذن لي حتى أصعد هذه الأعواد، فأتكلّم بكلمات لله فيهنّ رضا، ولهؤلاء الجلساء فيهنّ أجر وثواب، قال: فأبى يزيد عليه ذلك، فقال الناس: يا أمير المؤمنين، إئذن له فليصعد المنبر، فلعلّنا نسمع منه شيئاً، فقال: إنّه إن صعد لم ينزل إلّا بفضيحتي وبفضيحة آل أبي سفيان، فقيل له: يا أمير المؤمنين، وما قدر ما يحسن هذا؟ فقال: إنّه من أهل بيت قد زُقّوا العلم زقّاً، قال: فلم يزالوا به حتى أذن له، فصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم خطب خطبة أبكى منها العيون، وأوجل منها القلوب، ثم قال: أيّها الناس، أعطينا ستّاً...) المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص128. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص233. الحائري، جعفر عباس، بلاغة الإمام علي بن الحسين×: ص95.
[524] يُنظر: الاسترابادي، رضي الدين، شرح الكافية: ج1، ص11.
[525] ابن معصوم، علي بن أحمد بن محمد، أنواع الربيع في أنواع البديع: ج5، ص345.
[526] الرحمن: آية13.
[527] ابن فارس، أحمد، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: ص207.
[528] سيبويه، عمرو بن عثمان، كتاب سيبويه: ج1، ص62.
[529] الخطيب القزويني، محمّد بن عبد الرحمن، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع: ج2، ص52.
[530] الطبرسي، أحمد بن علي، الاحتجاج: ج2، ص32.
[531] عباس حسن، النحو الوافي: ج4، ص141.
[532] يُنظر: الراغب الأصفهاني، الحسين، مفردات ألفاظ القران: ص847 ـ 848.
[533] يُنظر: عباس حسن، النحو الوافي: ص142.
[534] النعيمي، سليم، اسم الفعل دراسة وتيسير، بحث منشور في مجلّة المجمع العلمي العراقي: مجلد 16، 1969 م: ص 78.
[535] حاتم حسن علي، أساليب التعجّب في القرآن الكريم، دراسة دلالية: ص148.
[536] الآلوسي، محمد، روح المعاني: ج10، ص237. موسوعة من حياة المستبصرين، مركز الأبحاث العقائدية: ج5، ص296.
[537] اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص244. الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص223.
[538] يُنظر: القيرواني، الحسن بن رشيد، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج2، ص74. الزركشي، بدر الدين محمّد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن: ج2، ص299.
[539] ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر، بلاغات النساء: ص23.
[540] المدني الشيرازي، علي خان الحسيني، رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين الإمام علي بن الحسين÷: ج4، ص12.
[541] إلياس ديب، أساليب التأكيد في اللغة العربية: ص9.
[542] يُنظر: عمّار حسن عبد الزهرة، أدعية الصحيفة السجّادية دراسة تداولية: ص100.
[543] يُنظر: القيرواني، الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ج2، ص74. الزركشي، بدر الدين محمّد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن: ج2، ص299.
[544] يُنظر: ميثم قيس مطلك، نثر الإمام الحسين× دراسة بلاغية: ص94.
[545] توفيق الفيل، بلاغة التراكيب (دراسة في علم المعاني): ص22.
[546] الصعيدي، عبد المتعال، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة: ص45.
[547] يُنظر: رجاء عجيل إبراهيم، الوظيفة في كتاب سيبويه: ص125.
[548] يُنظر: أحمد مطلوب، بحوث لغوية: ص40 ـ 41.
[549] الصرصري، البغدادي، سليمان عبد القوي بن عبد الكريم، الإكسير في علم التفسير: ص189.
[550] سيبويه، عمرو بن عثمان، كتاب سيبويه: ج1، ص34.
[551] يُنظر: البستاني، محمد، البلاغة الحديثة في ضوء المنهج الإسلامي: ص54.
[552] يُنظر: صحراوي، مسعود، الأفعال الكلاميّة عند الأصوليين، دراسة في ضوء اللسانيّات التداولية: ص247.
[553] الحلّي، ابن نما، مثير الأحزان: ص15. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص42. ابن أعثم الكوفي، أحمد، الفتوح: ج5، ص17. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص326.
[554] الصدر، محمد، أضواء على ثورة الحسين×: ص66 ـ 67.
[555] الحلّي، ابن نما، مثير الأحزان: ص38. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص316.
[556] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص315. المقرّم، عبد الرزاق، مقتل الحسين×: ص 195.
[557] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص32. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج7، ص318.
[558] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج33، ص79.
[559] موسوعة كلمات الإمام الحسين×، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×: ص572. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص118. ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص69. السماوي، محمد، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص36.
[560] لم ير زيادتها. يُنظر: المبرّد، محمّد بن يزيد، المقتضب: ج1، ص45، وقد حكم بزيادتها في مواضع أخرى. يُنظر: المبرّد، محمّد بن يزيد، المقتضب: ج4، ص52، ص136 ـ 138، ص420.
[561] يُنظر: ابن هشام الأنصاري، عبد الله، مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب: ج1، ص615.
[562] يُنظر: المصدر نفسه: ج1، ص615. السيوطي، جلال الدين، همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: ج2، ص. 35.
[563] السامرائي، فاضل، معاني النحو: ج4، ص622.
[564] وهذا خلاف ما نصّ عليه النحويّون والبلاغيّون، من أنّ هل لا تدخل على اسم يليه فعل إلّا على قبح كما يقول ابن يعقوب المغربي: (ولمجئ (الهمزة) دون هل فإنّها للتصديق فقط كما يأتي، لم يصح ورودها في التركيب الذي يكون الاستفهام فيه لطلب التصوّر، كطلب تصوّر الفاعل في قولك: (أزيد قام؟ )، بخلاف ورود (هل) في هذا التركيب الذي هو لطلب التصوّر غالباً، فلا يقال: (هل زيدٌ قام) إلّا على قبح). ابن يعقوب المغربي، أحمد بن محمد، مواهب الفتاح: ج2، ص251. ويُنظر: سيبويه، عمرو بن عثمان، كتاب سيبويه: ج1، ص101.
[565] يُنظر: ميثم قيس مطلك، نثر الإمام الحسين×، دراسة بلاغية: ص107.
[566] البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج4، ص214. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص297. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص270. الصدوق، محمّد بن علي، علل الشرائع: ج1، ص229.
[567] الصدر، محمد، أضواء على ثورة الحسين×: ص120.
[568] كالفرزدق والطرمّاح.. إلخ
[569] المرعشي النجفي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج27، ص201. البلاذري، أحمد بن يحيى، أنساب الأشراف: ج3، ص165. البحراني، هاشم، مدينة المعاجز: ج3، ص451.
[570] الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي: ص219. المرعشي النجفي، شهاب الدين، شرح إحقاق الحق: ج26، ص530. القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص63. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص164. المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص84.
[571] الصدر، محمد، أضواء على ثورة الإمام الحسين×: ص121.
[572] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص53. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: ص296.
[573] المطهري، مرتضى، الملحمة الحسينية: ص210 ـ 211.
[574] المصدر نفسه: ص212.
[575] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص549.
[576][576] يُنظر: الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ج1، ص105. ويُنظر: السامرائي، فاضل، معاني النحو: ج1، ص173.
[577] يُنظر: السامرائي، فاضل، معاني النحو: ج1، ص171.
[578] الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص311.
[579] يُنظر: بتول قاسم ناصر، دلالة الإعراب لدى النحاة القدماء: ص107.
[580] بدير متولّي حميد، لغة الإعراب: ص227.
[581] الواعية: الصارخة. يُنظر: المفيد، محمّد بن محمد، الإرشاد: ج4، ص84، ا لهامش.
[582] أبو مخنف الأزدي، لوط بن يحيى، مقتل الحسين×: ص92. الطبري، محمّد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص308. المفيد، محمّد بن محمد، الإرشاد: ج2، ص82. الأمين، محسن، لواعج الأشجان: ص 98.
[583] وهنا استلزم تنكير كلمة (أحد) العموم والإطلاق، أي: أنّ الكلام لايخصّ الحرّ فقط، وإنّما يشمل الحاضر والمستقبل.
المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص355. البحراني، عبد الله، العوالم، الإمام الحسين×: 674. المقرّم عبد الرزّاق، مقتل الحسين×: ص 195.
[585] موسوعة كلمات الإمام الحسين×، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×: ص490.
[586] المجلسي، محمّد باقر، بحار الأنوار: ج45، ص2.