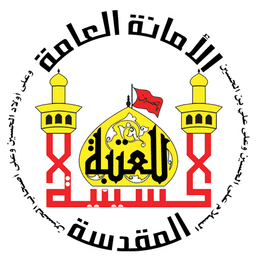ﭐ(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
صدق الله العلي العظيم
(آل عمران: 33 ـ34).
الرموز والمصطلحات المستخدمة في الرسالة
|
الرمـز |
المـعنى |
|
بلا. ت |
بلا تأريخ |
|
بلا. ط |
بلا مكان الطبع |
|
ت |
تأريخ الوفاة |
|
ص |
الصفحة |
|
ط |
مكان الطبع |
|
م |
السنة الميلادية |
|
هـ |
السنة الهجرية |
إلى...
الحبيبةِ التي ما رقدتْ عينايَ..
إلا ونورُها يتراءى لي عن كثبٍ...
وتشوّقُ لها نفسي...
ويهتفُ بي ضميري...
إلى أن أهدي لها المجهودَ الضئيلَ
فمنذُ أن مسكتُ القلمَ
لأخُطَّ أوَّلَ الحروفِ... كانالجهدُ
بإسمِ سيدتي ومولاتي زينبَ‘
الباحثة
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمدٍ المصطفى المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين.
وبعدُ…
فلا يسعني وأنا أكمل جهدي المتواضع هذا إلا أن أتقدَّم بفائق شكري وجزيل امتناني إلى أستاذي المشرف، الأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكيم على صبره وسعة صدره في تحمّله مراجعاتي المتكرّرة له، التي كان لها الأثر الأكبر في تصويب الرسالة، وكانت بصماته واضحة على كلِّ فصولها.
كما أتقدَّم بشكري وعرفاني إلى الأستاذ الدكتور عبد علي الخفاف عميد كلية الآداب، وإلى قسم التأريخ ـ رئاسةً وأساتذة ـ الذين قدّموا لي جهوداً متميزة في إخراج هذا الجهد بصورته النهائية، ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدّم بوافر تقديري إلى زملائي في اللجنة التحضيرية؛ لما قدّموه لي من مشورة وإرشاد إلى المصادر التي أسهمت في إتمام جهدي، كما أتقدّم بشكري إلى الأستاذ الفاضل هادي التميمي الذي أمدَّني بالكثير من المصادر، وكان له الأثر البالغ في توجيهي نحو الطريق الأصوب في إعداد الرسالة.
كما أتقدَّم بشكري إلى ملاك مكتبة كلية الآداب، ومكتبة الإمام الحكيم العامة ومكتبة أمير المؤمنين الذين أسهموا في تزويدي بالمصادر التي تطلبها البحث.
وأخيراً لا يسعني إلا أن أتقدَّم بعرفاني وشكري إلى زوجي وشريك حياتي الذي تحمَّلني بصبر طيلة فترة إعداد الرسالة.
مقدمة المؤسّسة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقية وسعادته الأبدية المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدد اختيارات الإنسان الصحيحة، وعلى ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله عز وجل على سائر المخلوقات، واحتج عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)[1] ، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، وقد جاء في الأثر «العلمُ نورٌ»[2]، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله، إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)[3]، وبهما تسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله عز وجل بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)[4]، و(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)[5]، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاؤهم^ ومبتغاهم من الله عز وجل لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»[6].
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه هي سيرة الأنبياء والأئمة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبي أو وصي، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أنيطت بهم^، كما أخبر عز وجل بذلك في قوله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)[7]، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقية سير الأنبياء، كما أنّ سيرة الأئمة^ ليست كبقية سير الأوصياء السابقين، كما أنّ التفاوت في سير الأئمة^ فيما بينهم مما لا شك فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقية الأئمة^.
والإمام الحسين× تلك الشخصية القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة التي دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الرباني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصية العظيمة التي ملأت أركان الوجود تعلَّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفية والعملية، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمس الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قبل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم وأفنوا أغلى أوقاتهم وزهرة أعمارهم لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفية التي تركها الإمام× للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفية في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: بل هي أكثر مما تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعددة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤولية المهتمين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق؛ بادرت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكرية والعلمية حول شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى والأساس بمسك هذا الملف التخصصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسية، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، التابعة للعتبة الحسينية المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميين ـ على شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطة مبرمجة وآلية متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلمية التخصصية، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينية المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصية الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلمية في المؤسسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسَّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلمية في المجال الحسيني، تمّ الوقوف على مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهميته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويات المعتمد في المؤسَّسة تمّ اختيار المشاريع العلميّة الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعية للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينية التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلمية وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث المكتوب عن مقتل الإمام الحسين×، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ ليتمَّ جمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتمُّ استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسَّسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد إخضاعها للتقييم العلمي من قبل اللجنة العلمية في المؤسَّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر تقوم المؤسَّسة بطباعتها.
الثاني: مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية والفقهية والأدبية في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلات العلمية الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلمية الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينية
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونية وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علميّ تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×
وهي موسوعة علمية تخصصية مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون ذلك من خلال جمع كلمات الإمام الحسين× من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية مع بيان لتلك الكلمات، ثمّ وضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام× والواقع العلمي.
الخامس: قسم دائرة معارف الإمام الحسين× أو (الموسوعة الألفبائية الحسينية)
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام وبلدان وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ حديث.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
إنّ العمل في هذا القسم يتمحور حول أمرين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة من قبل اللجنة العلمية في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية، تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
يقوم هذا القسم بمتابعة التراث المكتوب حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة باللغات غير العربية لنقله إلى العربية ومنها إلى لغات أخرى، ويكون ذلك من خلال تأييد صلاحيته للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ترجمته إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية في شتّى المجالات.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات العلمية
ويتمّ العمل في هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكرية متخصّصة في النهضة الحسينية، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، كما تتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلمية في المؤسَّسة، وكذا سائر الباحثين والمحققين وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينية وفق الأدوات الاستنباطية المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينية التخصصية
وهي مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسَّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصُّصها.
الحادي عشر: قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصِّص بنشر نتاجات وفعاليات مؤسَّسة وارث الأنبياء، يقوم بنـشر وعرض كتبها ومجلاتها التي تصدرها، وكذا الندوات والمؤتمرات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسَّسة، ومجمل فعالياتها العلمية والإعلامية.
الثاني عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصص وبأقلام علمية نسوية في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبية، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الثالث عشر: القسم الفني
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسَّسة، من خلال برامج إلكترونية متطوِّرة يُشرف عليها كادر فنيّ متخصِّص، يعمل على تصميم الأغلفة وواجهات الصفحات الإلكترونية، وبرمجة الإعلانات المرئية والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها كافّة الأقسام.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.
قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء
يتكفّل قسم الرسائل والأطاريح الجامعية بمهمّة نشر الفكر الحسيني المبارك، من خلال تفعيل الدراسات والأبحاث العلمية الحسينية في الأوساط الجامعية والأكاديمية بمستوياتها الثلاثة: البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، مضافاً إلى الرُقي بالمستوى العلمي والتحقيقي للكفاءات الواعدة المهتمّة بالنهضة الحسينية في جميع مجالاتها. وقد تصدّى لهذه المسؤولية نخبة من الأساتذة المحقِّقين في المجال الحوزوي والأكاديمي.
أهداف القسم
الغاية من وراء إنشاء هذا القسم جملة من الأهداف المهمّة، منها:
1ـ إخضاع الدراسات والأبحاث الحسينية لمناهج البحث المعتمَدَة لدى المعاهد والجامعات.
2ـ إبراز الجوانب المهمّة وفتح آفاق جديدة أمام الدراسات والأبحاث المتعلّقة بالنهضة الحسينية، من خلال اختيار عناوين ومواضيع حيوية مواكبة للواقع المعاصر.
3ـ الارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر الجامعية، والعمل على تربية جيل يُعنَى بالبحث والتحقيق في مجال النهضة الحسينية الخالدة.
4ـ إضفاء صبغة علمية منهجية متميزة على صعيد الدراسات الأكاديمية، المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة.
5ـ تشجيع الطاقات الواعدة في المعاهد والجامعات؛ للولوج في الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف مجالات البحث المرتبطة بالنهضة الحسينية، ومن ثَمّ الاستعانة بأكفّائها في نشر ثقافة النهضة، وإقامة دعائم المشاريع المستقبلية للقسم.
6ـ معرفة مدى انتشار الفكر الحسيني في الوسط الجامعي؛ لغرض تشخيص آلية التعاطي معه علمياً.
7 ـ نشر الفكر الحسيني في الأوساط الجامعية والأكاديمية.
8 ـ تشخيص الأبعاد التي لم تتناولها الدراسات الأكاديمية فيما يتعلّق بالنهضة الحسينية، ومحاولة العمل على إبرازها في الدراسات الجديدة المقترحة.
9ـ التعريف بالرسائل الجامعية المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ والتي تمّت كتابتها ومناقشتها في الجامعات.
آليات عمل القسم
إنّ طبيعة العمل في قسم الرسائل والأطاريح الجامعية تكون على مستويات ثلاثة:
المستوى الأوّل: العناوين والمواضيع الحسينية
يسير العمل فيه طبقاً للخطوات التالية:
1ـ إعداد العناوين والموضوعات التخصّصية، التي تُعنَى بالفكر الحسيني طبقاً للمعايير والضوابط العلمية، مع الأخذ بنظر الاعتبار جانب الإبداع والأهمية لتلك العناوين.
2ـ وضع الخطّة الإجمالية لتلك العناوين والتي تشتمل على البحوث التمهيدية والفصول ومباحثها الفرعية، مع مقدّمة موجَزَة عن طبيعة البحث وأهميته والغاية منه.
3ـ تزويد الجامعات المتعاقد معها بتلك العناوين المقترَحَة مع فصولها ومباحثها.
المستوى الثاني: الرسائل قيد التدوين
يسير العمل فيه على النحو التالي:
1ـ مساعدة الباحث في كتابة رسالته من خلال إبداء الرأي والنصيحة.
2ـ استعداد القسم للإشراف على الرسائل والأطروحات فيما لو رغب الطالب أو الجامعة في ذلك.
3ـ إنشاء مكتبة متخصِّصة بالرسائل الجامعية؛ لمساعدة الباحثين على إنجاز دراساتهم ورسائلهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من مكتبة المؤسَّسة المتخصّصة بالنهضة الحسينية.
المستوى الثالث: الرسائل المناقشة
يتمّ التعامل مع الرسائل التي تمّت مناقشتها على النحو التالي:
1ـ وضع الضوابط العلمية التي ينبغي أن تخضع لها الرسائل الجامعية، تمهيداً لطبعها ونشرها وفقاً لقواعد ومقرَّرات المؤسَّسة.
2ـ رصد وإحصاء الرسائل الأكاديمية التي تمّ تدوينها حول النهضة الحسينية المباركة.
3ـ استحصال متون ونصوص تلك الرسائل من الجامعات المتعاقَد معها، والاحتفاظ بها في مكتبة المؤسَّسة.
4ـ قيام اللجنة العلمية في القسم بتقييم الرسائل المذكورة، والبتِّ في مدى صلاحيتها للطباعة والنشر من خلال جلسات علمية يحضرها أعضاء اللجنة المذكورة.
5ـ تحصيل موافقة صاحب الرسالة لإجراء التعديلات اللازمة، سواء أكان ذلك من قبل الطالب نفسه أم من قِبل اللجنة العلمية في القسم.
6ـ إجراء الترتيبات القانونية اللازمة لتحصيل الموافقة من الجامعة المعنِيَّة وصاحب الرسالة على طباعة ونشر رسالته التي تمّت الموافقة عليها بعد إجراء التعديلات اللازمة.
7ـ فسح المجال أمام الباحث؛ لنشر مقال عن رسالته في مجلة (الإصلاح الحسيني) الفصلية المتخصِّصة في النهضة الحسينية التي تصدرها المؤسَّسة.
8 ـ العمل على تلخيص الرسائل الجامعية، ورفد الموقع الإلكتروني التابع للمؤسَّسة بها، ومن ثَمَّ طباعتها تحت عنوان: دليل الرسائل والأطاريح الجامعية المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة.
هذه الرسالة: السيدة زينب‘ ودورها في أحداث عصرها
إنّ من أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي بل والإنساني هو حادثة كربلاء ونهضة الإمام الحسين× العظيمة، فهي نهضة رسمت للأجيال اللاحقة طريق الصلاح والإصلاح، وأبرزت معالم منهج النجاح، فبدمه الطاهر أحيا الإمام الحسين× دين جدّه وهو الدين الخاتم، فبالحسين× يأبى الله إلّا أن يتمّ نوره.
فمن شارك بهذه النهضة القدسية، فقد شارك في حفظ الدين الإسلامي، وكلّما كانت المشاركة أوسع وأكبر كانت الشخصية أعظم.
والسيّدة زينب‘ هي أعظم شخصية حملت رسالة عاشوراء بعد الإمام السجاد×، حيث كان لها الدور البارز في تلك الواقعة العظيمة التي غيّرت مجريات التاريخ، فما بعد عاشوراء ليس كما قبلها وإلى يوم القيامة.
ومن هنا يتبيّن أنّ الدور الذي اضطلعت به السيّدة زينب‘ في أحداث عصرها دور مهم ومصيري وممتد في عمود الزمان، كما أنّ التعرّف على هذا الدور بشكل دقيق وواضح ما هو إلّا خارطة طريق ومشعل هداية تستنير به الأجيال وتسير على هدية، فهي‘ قدوة وأسوة.
وبذلك تتضح أهميّة هذه الدراسة في هذا الموضوع المهم الذي سلّطت فيه الباحثة الضوء على مسيرة السيّدة زينب‘ في تلك الظروف الصعبة والمسيرة الممتدة من المدينة وإليها.
نسأل الله أن يوفّق الباحثة لما فيه الخير والصلاح. وفي الختام نتمنّى للمؤلِّف دوام السداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، إنّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلمية في
مؤسسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
مقدِّمة قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يتربَّع الإمام الحسين× على قمّة سلّم الفضل والكمال في التاريخ الإسلامي والإنساني، فهو سبط خاتم الأنبياء وسيد المرسلين النبي محمد، وهو خامس أصحاب الكساء، وهو سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة، فجدُّه الرسول، وأمُّه الزهراء البتول، ووالده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فحاز المجد والشرف والفخار من كافَّة المطالع، وهو مع كلِّ ذلك قائد نهضة تاريخية عظمى، توفّرت فيها جميع الأسس والركائز النهضوية الواعية وطبعت بصمة واضحة جلية على صفحات الحضارة وصحائف التشريع، فباتت بحقٍّ الثورة الأمّ، والحركة النموذج، والإنطلاقة الأسوة،والعلامة المضيئة للمتنافسين في بلوغ الذُّرى، والساعين نحو البناء، والمتطلعين إلى أفق أجمل وأبهى والمنادين بالإنعتاق والحرية؛ أملاً في الإصلاح، ورغبة في رضا الحقِّ سبحانه.
ولأنَّ سيرة الإمام الحسين عليه السلام ونهضته المباركة وقيمه الإنسانية السامية تمثِّل القاعدة الأساس لمشروع نشاط قسم الرسائل الجامعية في مؤسَّسة وارث الأنبياء التابعة للعتبة الحسينية المقدَّسة، فقد تمَّ التواصل مع المعاهد والجامعات والأكاديميات العلمية، والباحثين والدارسين ، واتخاذ الإجراءات الضرورية بغية طبع الرسائل التي جعلت من الإمام الحسين× ونهضته الخالدة موضوعا لها؛ عملا على نشر الفكر الحسيني وتعميق الوعي بصحوته الربانية في الأوساط الجامعية والعلمية، وهكذا وقع الإختيار على هذه الرسالة المعنونة (السيدة زينب‘ ودورها في أحداث عصرها)، للباحثة هناء سعدون جبار العبودي التي حصلت بها على شهادة الماجستير من قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الكوفة.
والحقيقة أنَّ السيدة زينب‘ تقف شامخة في مقدِّمة صفّ نهضة عاشوراء، وتتفرَّد بدور مشهود في أحداث تلك الفترة الحرجة، التي شكَّلت منعطفا خطيرا في تاريخنا الإسلامي؛ وذلك بفضل ماأسدته من خدمات جليلة ومابذلته من جهود محمودة خلال كافّة محطات ومنازل المسيرة الحسينية، ولاسيما بعد وقائع العاشر من المحرم عام (61) للهجرة النبوية الشريفة، عندما تحتمَّ عليها أن تصبح العقيلة والسفيرة، فكانت نعم الساهرة على البقية الباقية من أهل البيت^ إثر الجرائم التى ارتكبها المعسكر الأموي بحقِّهم في طفوف كربلاء مما يندى له جبين البشرية، كما كانت نعم الصوت الذي رفع النداء عاليا جليا بقيم ومبادئ النهضة حتى في أشدّ المواقف خطرا وقسوة؛ كما حدث في مجلس عبيد الله بن زياد ويزيد بن معاوية، فأفحمت الأمراء والسلاطين وألهبت مشاعر الجموع والجماهير، ولا أدلّ على ذلك من خطبتها في أهل الكوفة التي تمثِّل علامة بارزة في الفصاحة والبلاغة وخطابها لعبيد الله بن زياد الذي انطوى على حجة بالغة أسكتت صوته وألَّبتْ عليه مجلسه، وتحدِّيها ليزيد بن معاوية في مجلسه بالشام؛ بكلامها المستنير، وبراهينها الدامغة، مما أذهله وألجمه وألجأه إلى البحث عن مخرج لمأزقه، وهو يتباهى بأفعاله الشنيعة، ويتمايل في خيلاء بين أفراد بلاطه وجلاوزة حاشيته، وشرذمة أتباعه غافلا عما يجلِّله من الخزي والعار.
وفي هذه الرسالة العلمية التي وقع عليها الإختيار للطبع تسعى الباحثة لتسليط الضوء بحثا وسردا وتحليلا؛ بغية الكشف عن بعض حقائق وأبعاد ذلك الدور الريادي الذي اضطلعت به السيدة زينب‘ في أحداث النهضة الحسينية، ذلك الدور الذي يأخذ بألباب الرجال والنساء على حدٍّ سواء، ويُشْدِهُ العقول ويهزُّ المشاعر، الأمر الذي جعل منها عليها السلام قبلة للتأسِّي وكعبة للاقتداء.
لقد توفَّرت الباحثة في دراستها المكوّنة من ثلاثة فصول على تبيان ما أمكنها تبيانه من العلامات المضيئة والمواقف الإنسانية النبيلة في سيرة وحياة السيدة زينب‘، فأفردت فصلا تمهيديا حول اسمها ونسبها ومولدها‘، وكذلك حول نشأتها وحياتها الإجتماعية، وفضائلها وعلمها، ثم توقَّفت في الفصل الثاني عند أهمِّ أحداث النهضة الحسينية خلال المسيرة من المدينة المنورة إلى كربلاء بما في ذلك وقائع معركة الطف، وشهادة الإمام الحسين‘ مع تلك الثلَّة الخالصة المخلصة من أهل بيته وأصحابه، ثم مأساة الأسرى والسبايا، وطبيعة الدور الزينبي خلال هذه الحقبة المريرة، وكيف واكبت وشاركت وواست أخاها الحسين‘ في كافَّة مراحل نهضته، وكيف أنَّبَتْ عمر بن سعد على جُبنه وصَغَاره، وأطماعه الدنيوية التي لن يصل إليها ولن تصل إليه، ثم كيف عاتبت وبكَّتَتْ أهل الكوفة بخطبتها العصماء الشهيرة، ومسَّتْ منهم الشِّغاف، ولفتت الإنتباه، فبُهِتُوا وظلُّوا في حيرة من أمرهم، وكيف زأرتْ كالليث الهَصُور في وجه ابن زياد في قصر الإمارة، وكيف حالتْ بين الإمام زين العابدين السجاد× وابن زياد بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الوقوع في براثن الطاغية. ثم تنتقل الباحثة إلى الفصل الثالث والأخير، وفيه يتجلَّى دور السيدة زينب بنت علي÷، ويصبح جسيما منذ الخطوة الأولى من حركة رَكْب الرؤوس والأسارى في الطريق من الكوفة إلى بلاد الشام، ودخول السبايا إلى مجلس يزيد بن معاوية، وموقفها‘ من المجتمع الشامي، وتحدِّيها السافر ليزيد في مجلسه، ثم مواصلة رسالتها الإعلامية والتوعوية العظيمة بعد عودتها إلى المدينة المنوَّرة. وبغضِّ النظر عما يعتور هذه الدراسة من هنات طفيفة فإنَّ جهد الباحثة يبقى محلّا للتقدير، ورسالتها تبقى ذات قيمة في حقل الدراسات الحسينية المتعدِّد الأبعاد والمترامي الأطراف.
قسم الرسائل الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء
بسم الله اللرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين، سفن النجاة ومنارات الهدى إلى يوم الدين، وصحبه الكرام الطيبين.
وبعدُ، فإنَّ الظلم عندما ينشر أجنحته على المجتمع، ويمدُّ سيقانه البغيضة في حياة الأمم، تضطرُّ العدالة للانسحاب من مواقعها، ويبدأ الجور بسلب الحقوق والكرامات، وتصبح المصالح والرشوات هي لغة التعامل، حينها يسود الإنحراف حياة الناس، فيصبح الدين اسماً والقرآن رسماً، وتتبخَّر قيم الإسلام ومفاهيمه، وبالمقابل تتورَّم طقوسه وقشوره، فيصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، فيتسلَّل إلى قيادة الأمة طغاة مستبدون، يحكمون باسم الإسلام في الوقت الذي يفتكون بقيمه وينسفون مبادءه، بعد أن فرضوا أنفسهم بالقوة دونما أيَّة مؤهَّلات ترشّحهم للخلافة والحكم.
إنَّ الأمَّة عندما تُبتلى بمثل هذا الواقع، وتعيش في أتون مثل هذه الحالة، تجد أنَّ سنَّة الله سبحانه وتعالى في طريق تهذيبه لخلقه وتدبيره لملكه، يصطفي بين الحين والآخر بعض ذوي النفوس العالية، والأرواح السامية، ليضرب بها الأمثال، تارة في قوَّة الإيمان وصدق اليقين، وأخرى في الصبر على البلاء، والشكر في السَّرَّاء والضَّرَّاء، وثالثة في رباطة الجأش في الملمَّات؛ ليتذكّر الناس مواقفهم الباهرة وسيرهم العطرة، ويدركوا ما يمكن للإيمان أن يحقِّق من إعجاز، وسواء انتصر مثل أولئك المصطفين المختارين من الله عزَّت قدرته في كفاحهم، أم استشهدوا فقد يُخلَّدون في سجل التأريخ، ويكفلون بتضحياتهم تلك استمرار الحياة بمبادئها الناصعة، ملاقين ربهم فرحين مستبشرين؛ إذ لا فرق في نظر دعاة الحقّّ بين الحياة والموت، وبين النصر والشهادة، فلرُبَّ شهادة في ميدان الشرف والخلود أكرم من ألف نصر عسكري، ورُبَّ بلاء أنفع في ظهور الحقِّ وأقطع في مقاومة الباطل من السلامة والنجاة.
ولعلَّ من أروع صفحات الخلود في التأريخ الإسلامي، ما سطَّره أهل البيت^ في كربلاء من صفحات خالدة تحت لواء سيد الشهداء وسبط سيد الأنبياء، مع أخته السيدة زينب^، فمثلما سطَّر أبو الشهداء الإمام الحسين× أروع دروس البطولة وأصدق آيات الإيمان، فقد ضربت السيدة زينب‘ أمثلة عظيمة لمعاني الصبر على المصاب، والثقة بالله في مواطن البلاء، وكيف تكون العزّة والكرامة حتى أذلَّت تلك الأسيرة الطغاة المتكبرين، فكانت في ضعفها ووحدتها أعظم قوة من آسريها، فضلاً عن دورها في الحفاظ على بيت النبوة من الزوال، وفضح أكاذيب السلطة الجائرة بما قامت به من دور إعلامي متحّرك حفظ للتأريخ مراحل الثورة الحسينية.
وليس من السهولة عرض سيرة حياة شخصية لا نجد لبدايتها أو خاتمتها ما يروي ظمأ الباحث من روايات تأريخية مما يضطرُّه إلى أن يقرأ مابين السطور علّه يستشفُّ شيئا عن كنه تلك الشخصية، فيصطدم بما حُرِّفَ وما حُذِف من الروايات التأريخية في سعي حثيث لتشويه تلك الشخصية؛ وصولا إلى تشويهٍ للبيت الذي انحدرت منه، مما يحول دون الوصول إلى الحقائق كاملة، والتي تمثِّل هدف الباحث الذي يسعى إلى تحقيقه.
وقد استعنت بالله، على الرغم من تلك الصعوبات والمعوّقات، واخترت «السيدة زينب بنت عليّ÷ودورها في أحداث عصرها» موضوعاً لبحثي، وقد دفعتني للكتابة في هذا الموضوع رغبتي في الكتابة عن رمز من رموز آل البيت^ تتجلَّى فيه المعاني السامية التي تجسّدت فيها مفاهيم الاسلام وأخلاقه، والروح الجهادية سواء في ذلك في حياتها في كنف أبيها أم في ظلّ أخويها، أم في ممارسة دورها الجهادي في معركة الطف، وإنَّ دراستنا الأكاديمية تفتقر إلى مثل هذا النوع من الدراسات؛ نتيجة الحظر الذي فـُرض عليها لسنوات طويلة.
وقد قسَّمت الدراسة إلى مقدمة وثلاثة فصول، رتّبتُ فيها الفصول ترتيباً زمنياً وموضوعياً، ضمّ مراحل حياتها وجهادها الذي ترك آثاره في أحداث عصرها، ومن هنا جاء الفصل الأول مبيّـناً اسمها ونسبها ومولدها وأبرز الكنى التي كُنيّـتْ بها ونشأتها الأولى، على الرغم من شحَّة المصادر التأريخية التي تناولت حياة السيدة زينب‘ في تلك الفترة، ثم تناولت زواجها، وأولادها، وسلَّطت الضوء على بعض فضائلها ومناقبها وعلمها.
أما الفصل الثاني فقد خُصِّص لواقعة الطف المريعة التي تعدُّ أهمّ أحداث العصر الذي عاشته السيدة زينب‘، لذلك كان من المهمِّ أن نوضِّح عبر مباحث هذا الفصل دورها‘ في تلك الأحداث، وقد سلَّطت الضوء في هذا الفصل على أخذ البيعة ليزيد في حياة والده معاوية، وما جرَّ ذلك على الأمة الإسلامية من بلاء بعد هلاك معاوية، وكيف أنَّ الإمام ترك المدينة باتجاه مكة، ومنها إلى كربلاء حيث حلَّت الفاجعة بآل بيت الرسول’؛ موضِّحة دور السيدة زينب‘ في كلِّ تلك الأحداث، وخاصة تحملها المسؤولية الكبرى في مواصلة الرسالة التي بدأها الإمام الحسين×.
أما الفصل الثالث فقد كان إستكمالاً لدور السيدة زينب‘ في الحفاظ على عدم انقطاع نسل آل محمد’ من الأرض، والحفاظ على الأطفال والنساء، ومواجهة محاولات الدَّسِّ والتزييف التي حاولت السلطة الأموية بثَّها في صفوف أهل الشام ومن جاورهم، ثم تمَّ تسليط الضوء على دورها‘ في ديمومة زخم الثورة، وإيصال الصورة الصادقة عنها للناس، ولولا موقفها في تلك الأحداث وخاصة في مجلس يزيد وتحدِّيها للسلطان الجائر وفضح أساليبه لضاعت أخبار الثورة الحسينية، وخصَّصتُ المبحث الأخير من هذا الفصل لقضية شائكة لاختلاف المصادر التأريخية فيها، ولعدم وجود مصادر تأريخية متقدمة توضِّح الحقيقة، وأقصد بها قضية وفاتها ومرقدها‘، محلِّلة كلَّ رواية من الروايات مبيّـنة نصيبها من الصحة أو الخطأ، مع اختيار الرأي الأرجح لديَّ في هذا الموضوع.
وفي الخاتمة أوضحت أهمَّ النتائج التي توصَّل إليها البحث، وأعقبته بثبت للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في كتابة الرسالة، وكانت خاتمة المطاف مع ملخَّص الرسالة باللغة الإنجليزية.
وقد اعتمدتُ في رسالتي هذه على كثير من المصادر الأساسية والمراجع الحديثة، فكان القرآن الكريم النبراس والمنهل الذي نهلت منه؛ إذ كان أحد أهمِّ المصادر الرئيسة التي لا غنى لأيِّ باحث عنه، وهو يخوض في غمار موضوع يمسُّ أصول العقيدة الإسلامية، وقد أعانني على استخراج الآيات الكريمة بسهولة ويسر كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، الذي وضعه محمد فؤاد عبد الباقي، وأسهمت كتب الحديث من كتب الصحاح في إضفاء معلومات قيمة، أو للاستدلال على مواقف تأريخية، فكان كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري (ت 256 هـ)، وكتاب سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى الترمذي (297 هـ)، وصحيح مسلم، للإمام مسلم (ت 261 هـ)، وقد أفادتني هذه الكتب في توثيق الأحاديث النبوية الشريفة التي تخصُّ ذكر مناقب آل البيت^.
أما كتب التراجم والطبقات فكان كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (ت 230 هـ) من المصادر المهمَّة في بيان ترجمة العديد من الشخصيات التي ورد ذكرها في الرسالة.
وقد استعنت بكتب التأريخ العام الموضوعية منها والحولية؛ لما فيها من قيمة تأريخية، ويأتي في المقدمة منها تأريخ اليعقوبي (ت 292 هـ)، على الرغم من الإختصار الذي امتازت به رواياته، وكتاب (تأريخ الرسل والملوك) لمحمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ) على الرغم من افتقاره إلى نقد الروايات وترجيحها وكتاب (الكامل في التأريخ) لابن الأثير (ت 630 هـ) الذي تناول روايات كتب التأريخ التي سبقته بالنقد والترجيح.
ومن الكتب المهمة الأخرى التي أفادتني في كتابة الرسالة كتاب (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني (ت 356 هـ)، الذي قدَّم لنا وصفاً وافياً لكلِّ مَنْ طاله القتل من آل أبي طالب على مرِّ تأريخ الدولة الإسلامية، وكتاب (الإرشاد) للشيخ المفيد (ت 413 هـ).
كما كان للمعاجم اللغوية دور في إغناء الرسالة من حيث شرح المفردات الغريبة، ومنها معجم (مقاييس اللغة) لأحمد بن فارس (ت 395 هـ)، و(لسان العرب) لابن منظور (ت 711 هـ)، و(المعجم الوسيط) للفيروز آبادي(ت 817 هـ).
وكان لكتابات البلدانيين مكانة مهمة في رسالتي، فعلى الرغم من أنّ هذه الكتب تُعنى بالمواقع والبلدان إلا أنَّها تحوي بين دفتيها العديد من الروايات التأريخية التي أفدت منها، من هذه الكتب كتاب (معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع) لأبي عبيد البكري (ت 487 هـ)، و(معجم البلدان) لياقوت الحموي (ت 626 هـ) الذي كان له أثر مهمّ في توضيح المناطق ومعرفة بعض تفاصيل الأحداث التأريخية التي حدثت فيها، ورغم أنّ كتاب ابن عبد الحقِّ البغدادي (ت 739 هـ) الموسوم بـ (مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع) هو مختصر لكتاب ياقوت (معجم البلدان)، فإنه أفادني ببعض المعلومات البسيطة في الرسالة.
أما المراجع الحديثة فكان لها دور كبير في إغناء الرسالة بكثير من الأمور وبخاصَّة وصفها الوقائع التأريخية، ويأتي في مقدمتها كتاب (زينب الكبرى من المهد إلى اللحد) للقزويني، وكتاب (زينب الكبرى بنت الإمام علي×) لجعفر النقدي، وكتاب (مرقد العقيلة زينب) لمحمد حسنين السابقي، وكتاب (بطلة كربلاء) لبنت الشاطئ، وكان لكتاب حسن موسى الصفار (المرأة العظيمة) فائدة جمَّة في تحليل كثير من الأحداث التأريخية وبخاصة في موضوع مرقد السيدة زينب‘، ولعلَّ الفائدة القصوى للمراجع الحديثة تكمن في ما يمكن أن يستخلص الباحث منها، إذ يستطيع الباحث ـ وهو يتأملها ـ أن يستشفّ حقائق عن بعض مراحل حياة السيدة زينب‘، إذ لا يجد الباحث في المصادر التأريخية القديمة، ما يروي ظمأه، وقد أشرت للأمانة العلمية إلى أنّي قد أخذت الرواية كما وجدتها، ولم أجد ما يقابلها في المصادر القديمة.
وعلى الرغم من أنّي تجاوزت الفترة المحدَّدة لكتابة الرسالة بأخذي وقتاً إضافياً،إلاأنَّ المصاعب رافقتني كما رافقت باقي زملائي، إذ إنَّ التغير السياسي الذي حلّ بالعراق، واحتراق المكتبات العامة، وغلق الأخريات، فضلاً عن الوضع الأمني الخطر الذي قلَّل من فرصة الإطلاع على كثير من المصادر، ولكنّ الله هيَّأ لي سفر بعض الزملاء إلى خارج العراق فاستعنت بهم للحصول على بعض المصادر المهمة، مضافاً إلى تعاون أساتذتي في قسم التأريخ وأستاذي المشرف في تذليل تلك المصاعب.
ـ والله الموفق ـ
الباحثة
الفصل الاول
المبحث الأول: اسمها ـ نسبها ـ مولدها
المبحث الثاني: التسمية ـ الكنى والألقاب ـ النشأة
المبحث الثالث: زواجها ـ أولادها
المبحث الرابع: فضائلها ـ مناقبها ـ علمها
المبحث الأول
هي السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب، بن عبد المطلب، بن هاشم،بن عبد مناف، بن قصي[8]، بن كلاب، بن مرة،بن كعب، بن لؤي، بن غالب، بن فهر ابن مالك، بن النضر، بن كنانه، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، ابن سعد، بن عدنان[9].
وأبوها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بن عبد المطلب، بن هاشم، بن عبد مناف، بن قصي[10]، الهاشمي القرشي، يجتمع هو ورسول الله’ في جدِّهما عبد المطلب؛ إذ كان عبد الله والد الرسول’ وأبو طالب والد علي× أخوين من الأمِّ والأب، وأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومي القرشي[11]، أما جدتها لأبيها فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، تجتمع هي وأبو طالب في هاشم بن عبد مناف[12]، فهي «أول هاشمية ولدت لهاشمي»[13]، فولدت له علياً وجعفراً وعقيلاً وطالباً[14]، وأمَّ هانيء، وجمانة، وريطة وكلُّهم أبناء فاطمة وأبي طالب، وقد ولد علي× في مكة المكرمة، وتواترت الروايات في أنَّه المولود في الكعبة المشرَّفة في الثالث عشر من شهر رجب، سنة ثلاثين من عام الفيل[15]، واستشهد× قبل الفجر ليلة الجمعة في الحادي والعشرين من شهر رمضان، سنة أربعين للهجرة بسيف الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي في مسجد الكوفة[16]، وهو ابن ثلاث وستين سنة[17].
أمَّا أمُّها فهي فاطمة بنت رسول الله محمد’، وجدَّتها لأمِّها خديجة بنت خويلد ابن أسد بن عبد العزى بن قصي[18]، وُلدت فاطمة قبل البعثة بخمس سنين، وهي صغرى بنات الرسول’[19]، وتوفيت على أغلب الروايات بعد وفاة الرسول بستة أشهر[20]، ومناقب فاطمة‘ كثيرة غير خفية على من ينظر في تاريخ حياتها‘[21].
وأخوتها الإمام الحسن بن علي×[22]، والإمام الحسين×[23]، والمحسن، وأمُّ كلثوم[24].
أما إخوانها وأخواتها لأبيها فهم محمد بن الحنفية(*)، وأمُّه خولة بنت إلياس الحنفية[25]، والعباس، وجعفر، وعبدالله، وعثمان وأمُّهم أمُّ البنين بنت حزام الكلابية، وكلُّهم قُتلوا مع الإمام الحسين× في كربلاء، ولا بقية لهم سوى العباس عليه السلام[26]، وعبدالله وأبي بكر، وأمُّهم ليلى بنت مسعود النهشلية[27]، وعمر ورقية وأمُّهما تغلبيه[28]، ومحمد الأصغر ويحيى وأمُّهما أسماء بنت عميس الخثعمية، ومحمد الأوسط وأمُّه أُمامة بنت أبي العاص، أمُّها زينب بنت رسول الله’، وأمُّ الحسن ورملة الكبرى وأم كلثوم، وأمُّهم أمُّ سعيد ابنة عروة بن سعيد الثقفية[29].
وكان لها أخوات من أمهات شتى؛ أمُّ هانئ، وميمونة، وزينب الصغرى ورملة الصغرى، وأمُّ كلثوم الصغرى، وأمامة، وخديجة، وأمُّ كلثوم، وأمُّ سلمة، وأمُّ جعفر الجمانة، ونفيسة وكلهنَّ من أمهات أولاد[30].
وعلى ذلك يكون إخوتها أربعة عشر ذكراً، وسبع عشرة أنثى، كان النسل منهم للحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس وعمر بن التغلبية[31].
اختلف المؤرخون في ولادة السيدة زينب‘؛ فقد ذكر بعضهم أنَّها وُلِدت في شعبان، في السنة السادسة للهجرة، وعاشت مع جدِّها رسول الله’ خمس سنوات[32]، فيما ذكر آخرون أنَّها وُلِدت في السنة الخامسة للهجرة[33]، وقيل : في السنة الرابعة للهجرة[34]، أو التاسعة للهجرة[35]، ويبدو أنّ القول الأخير ليس له نصيب من الصحة؛ فإذا كانت ولادتها في السنة التاسعة للهجرة، وتوفي الرسول’ في السنة الحادية عشرة للهجرة[36]، وتُوفيت أمُّها بعد الرسول بستة أشهر على أصحِّ الروايات، فكيف تكون زينب كبرى بنات فاطمة كما صرح بذلك أغلب المؤرخين؟ ومتى كانت ولادة أم كلثوم؟ ومتى حملت بالمحسن[37]؟ وعلى أغلب الظنِّ أنَّ السنة الخامسة للهجرة هي الأقرب إلى الصحة؛ لكي تستطيع السيدة زينب أن تروي لنا خطبة فاطمة الزهراء بعد وفاة الرسول’، كما سنرى فيما بعد.
التسمية ـ الكنى والألقاب ـ النشأة
الأسم عند النحاة هو ما دلَّ على مُسمَّى دلالة إشارة، واشتقاقه من السِّمَة، وهي العلامة؛ لأنَّه يصير علامة المسمى يميزه عن غيره[38]، وكان الرسول الكريم محمد’ هو الذي يتولَّى تسمية أولاد علي وفاطمة‘، فهو الذي سمَّى الحسن والحسين×، وهو الذي سمَّى زينب‘ أيضاً، فبعد ولادتها جاءت بها أمُّها فاطمة الزهراء‘ إلى أبيها أمير المؤمنين×، وطلبت منه تسمية المولودة فقال×: ما كنت لأسبق رسول الله’، وكان في سفر له، فلما جاء’ وعلم بمولدها سأل عن اسمها، فقال علي× : ما كنت لأسبقك يا رسول الله’، فسمَّاها الرسول الكريم زينب، ويقال : إنَّ جبرئيل× طلب بأمر من الله تعالى أن يطلق عليها هذه التسمية، وأخبر الرسول’ بما يجري عليها من المصائب؛ فبكى الرسول لذلك[39].
وفي رواية أنّ الرسول’ سمَّاها بهذه التسمية؛ تسلية لنفسه بعد وفاة ابنته زينب إذ كان يحبُّها حبَّاً جمَّاً، فلما وُلدت السيدة زينب، سمَّاها الرسول باسم ابنته التي توفيت في السنة الثانية للهجرة[40].
وأكثر أسماء العرب منقولة عما لديهم مما يدور في خزائن خيالهم، إمَّا من أسماء الحيوان، أو من أجزاء الأرض، أو من أسماء الشجر[41]، وعلى ما نظنُّ أنَّ اسم السيدة زينب‘ جاء وفق هذا السياق.
فالزينب في اللغة الشجر الحسن المنظر طيب الرائحة، وبه سُمِّيت المرأة، وواحد الزينب للشجر زينبه[42]، والكلمة مكوَّنة من مقطعين (زين) و(أب)[43]، والباء والنون أصل صحيح يدلُّ على حسن الشيء، وازَّينت الأرض إذا حسن عشبها وازدانت[44]، والزينة ما يُتزيَّن به[45]، وعلى ما يبدو أنَّ الكلمتين دُمجتا فأصبحتا زينب وتعني زينة الأب[46].
أما الكُنية بضمِّ الكاف فهو ما صُدِّر من الأعلام بأبٍ أو أمٍّ؛ كأبي الحسن، وأمِّ كلثوم، وأمِّ الحسين، والتكنية مستحبة بإضافة الكنية إلى الاسم؛ حذراً من لحوق النبز وهو ما يُكرَه من اللقب، وجاء في الحديث «إنَّا نكني صغارنا؛ حذراً من النبزات» فكنى الرسول’ نفسه بأبي القاسم، وكانت كنية أمير المؤمنين أبا الحسن وأبا تراب، وأصبح ذلك سُنَّة للمسلمين[47].
وجريا على ذلك كنيت السيدة زينب× بأمِّ كلثوم، وكانت هذه الكنية سبباً لأن يقع كثير من المؤرخين في خطأ فاحش بين زينب‘ وبين بنت أخرى للإمام علي× اسمها أمُّ كلثوم، فنسبت أخبار إحداهما إلى الأخرى، فأمُّ كلثوم الثانية لُقِّبت بـ(الصغرى)، وقيل أنها هي التي خطبها الخليفة عمر بن الخطاب قبل أن تبلغ الحلم، وفي قول آخر تزوَّجها [48]، وهذه المسألة موضع خلاف شديد في كتب التاريخ، وليست موضوع بحثنا، وعلى أية حال فإنَّ كلتا الحالتين تدلِّلان على أنَّها غير زينب‘ التي تكنَّت بأمِّ كلثوم وبه عُرِفت، وقد أجمع كثير من المتأخرين بأنَّ لزينب‘ كنية أخرى هي أمُّ الحسن[49]، وعلى ما يبدو أنَّ هؤلاء المتأخرين اعتمدوا على ما قاله ابن عنبه الذي انفرد في إطلاق هذه الكنية عليها [50].
أما اللقب في اللغة فأصله النبز؛ أي ذكر العيوب، لكن العامة إستعملت اللقب في موضع الصفة الحسنة، حتى وقع الإتفاق والإصطلاح على استعماله في التشريف والإجلال والتعظيم والزيادة في النباهة والكرامة[51]، وجرياً على ذلك فقد لُقِّبَت السيدة زينب‘ بألقاب عديدة، كان لها مساس كبير بالدور البطولي الذي خاضته؛ لأجل تكملة مسيرة الإمام الحسين× بعد واقعة الطف في كربلاء، وقد أُطلق قسم من هذه الألقاب عليها في حياتها، والقسم الآخر بعد وفاتها. ويبدو لي أنّ بعض هذه الألقاب تكاد تكون لمؤرِّخين متأخرين. فمنهذهالألقاب (العقيلة)، وقولهمفلانةعقيلةقومهافهيكريمتهمومنخيارهم، وعقيلةكلِّ شيء أكرمه[52]، وهي في الأصل المرأة الكريمة النفيسة، وعقائل البحر درره، واحدته عقيلة والدُّرَّة الكبيرة الصافية عقيلة البحر، وجمعها عقائل[53]، وسُمِّيت المرأة بالعقيلة؛ لأنَّها عقلت صويحباتها عن أن يبلغنها، ومعناها أيضاً السيدة التي عقلت في خدرها[54]، وقد روى ابن عباس عن السيدة زينب‘ كلام فاطمة× في فدك فقال: «حدثتنا عقيلتنا زينب بنت علي»[55].
ومن ألقابها‘ العابدة و«العبد: الإنسان، حراً كان أو رقيقاً، يذهب بذلك إلى أنَّه مربوب لباريه، جلَّ وعزَّ...»[56].
والعابدة من العابد أو العبادة، وهو الخاضع لربِّه المستسلم المنقاد لأمره، ومؤنثه العابدة[57]، ولقد كانت زينب مثالاً للعابدة الخاضعة لربها كما سنرى في سياق حديثنا عنها، ومن ألقابها الفاضلة من الفضل والفضيلة ضد النقص والنقيصة[58]، وهي الغالبة بالفضل[59]، ومن ألقابها الكاملة من الكمال، وتمام الشيء كماله؛ فيقال رجل كامل وامرأة كاملة[60]، ومن ألقابها أيضاً العالمة، والعلم نقيض الجهل، ورجل عالم وعليم من قوم علماء، ومؤنثهُ عالمة، ودليل إطلاق ذلك اللقب عليها قول الإمام علي بن الحسين× لها عندما خطبت في الكوفة «اسكتي يا عمَّة أنت عالمة غير معلَّمة وفاهمة غير مُفَهَّمَة»[61].
ومن الألقاب الأخرى لقب الصدِّيقة الصغرى؛ تمييزاً لها عن أمِّها فاطمة الزهراء‘ الملقَّبة بالصدِّيقة الكبرى، ومن ألقابها أيضاً حفيدة الرسول’ وبضعة البتول[62]، ونظنُّ ـ كما قلنا ـ أنّ أغلب هذه الألقاب وغيرها أطلقها المؤرِّخون المتأخرون؛ لأنَّنا لم نجد لها أي إشارات في المصادر التاريخية المتقدمة.
ومن ألقابها الأخرى الصابرة، ولما كان الصبر وعدم الجزع عند نزول البلاء من حسن التوفيق وأمارات السعادة[63]، بدليل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)[64]. فإنَّ من الأمور المتواترة في التأريخ عن إحدى أهمِّ صفات السيدة زينب‘ هو صبرها وعدم جزعها، وتصدِّيها للأمور الجسام عند نزول البلاء والمصائب؛ ولذلك حقَّ لها أن تلقَّب بالصابرة.
أمَّا نشأة السيدة زينب‘ فإنَّ قلة المصادر التاريخية التي تناولتها ضيَّعت علينا مرحلة تاريخية مهمة من حياة هذه السيدة العظيمة، ونظنُّ أنَّ السبب الرئيس في إغفال المؤرَِّخين لهذه المرحلة من حياتها يرجع إلى أنّ العرب عموماً لم يركِّزوا على أخبار النساء، كما أنّ الأحداث التاريخية المهمة التي مرَّت بها الأمة الإسلامية وهي في بداية عهدها جعلتهم يسلِّطون الأضواء على تلك الأحداث، وإغفال مادونها من الأهمية لذلك لم نحصل على تفاصيل دقيقة عن نشأة هذه السيدة في طفولتها وصباها، كما أنّ من الواضح أنّ نقل الحوادث التاريخية غالباً إنما يكون لمجتمع الرجال إلا ما ندر؛ إذ لم يكن الحال على ماهو عليه عالمنا اليوم من بروز النساء واختلاطهنَّ بالرجال، مما ينتج عنه بطبيعة الحال التكتُّم والتعتيم على مجمل أخبار النساء، وخاصة نساء بيت النبوة إلا في حدود ما تقتضيه المصلحة من إعلانه ونشره[65].
وضمن هذا السياق ينقل أنّ أمير المؤمنين علي× كان يخرج السيدة زينب إلى المسجد في الليل فيخفت القناديل كي لا يراها الرجال[66]، أو الرواية التي تقول أنّ رجلاً جاور علياً× عشرين عاماً فلم يسمع خلال هذه الفترة الطويلة لزينب‘ صوتاً، أو يرى لها شخصاً[67].
وعلى الرغم من كلِّ ذلك حاولنا أن نقرأ ما بين السطور للوصول إلى بعض الأخبار التي تسلِّط الضوء على تلك المرحلة من حياتها.
فالسيدة زينب‘ نشأت وترعرعت في بيت النبوة والوحي، وأهل هذا البيت هم الذين تولَّوا تربيتها وتعليمها، وهم الذين قال عنهم الله تعالى في محكم كتابه الكريم: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)[68]فهي قد نشأت في أسرة تنتهي إليها كلُّ مكرمة وفضيلة، فهم أوَّل الناس اسلاماً وهم المجاهدون لإعلاء كلمة الله، فنشأت في هذه الأجواء، فجدُّها رسول الله’ كان يغدق عليها بحنوِّه وحبِّه وعلمه، وهو الذي كان المشرف الأول على تربية ولد فاطمة؛ إذ كان’ يقول «كلُّ ولد أب فإنَّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا أبوهم وعصبتهم»[69].
وعلى الرغم من أنّ المصادر التاريخية قد أمسكت عن إعطاء التفاصيل حول السنوات التي عاشتها السيدة زينب‘ في ظلِّ الرسول’، إلا أنَّ هناك بعض المرويات التي تذكر أنّ السيدة زينب‘ كان لها حوار مع جدِّها محمد’، وسواء صحَّت تلك المرويات أم لم تصحَّ فإنَّ الأمانة العلمية تدعونا إلى ذكر مثل هذا الخبر[70].
إنَّ علماء النفس التربوي يقولون: إنّ الطفل بعد أن يتمَّ الثالثة من عمره تبدأ مرحلة التوافق بينه وبين بيئته، ويبدأ بالتمييز بين الألفاظ والمعاني، وإنَّ نموَّه العقلي في هذه السن يتجه به إلى محاولات الكشف عما يحيط به، مما يرى ويسمع وإنَّ مجموع تلك الإكتشافات تترك أثارها في نفس الطفل حتى أخريات أيام حياته، ومما لاشكَّ فيه أنَّ ما عاشته السيدة زينب من سنوات ستٍّ مع أمِّها فاطمة‘ قد ترك أثره في زينب التي كانت ترى أمَّها تؤدي الفرائض، وتطعم الطعام مسكيناً ويتيماً وأسيراً، وتلبس الثياب الخلقة فيما تكسو الفقراء جديد الثياب[71].
ولقد كانت السيدة فاطمة‘ أحبَّ الناس إلى رسول الله’، فقد سئلت عائشة عن أيِّ الناس أحبُّ إلى رسول الله’ قالت: فاطمة، فقيل لها: ومن الرجال؟ قالت زوجها؟ ! أن كان ما علمت صوّاماً قوّاماً[72]، وباختصار فإنّ زينب‘ رأت جدَّها الرسول’ مُمَثَّلاً في أمِّها فاطمة الزهراء‘ وأبيها أمير المؤمنين× بجميع صفاته ومزاياه’، وقد أوضحت ذلك وهي ترثي والدتها الزهراء‘ قائلة «يا أبتاه يا رسول الله ألآن حقاً فقدناك فقداً لا لقاء بعده»[73].
إنَّ صفات الزهراء‘ قد انعكست في نفس زينب‘؛ عبادة وصبراً وجرأة ً، وظهر ذلك واضحاً وجلياً في واقعة الطف، وفي ليلة العاشر والحادي عشر من محرم؛ إذ كان أخوها وأولاده وأصحابه مجزَّرين كالأضاحي، ولم يمنعها ذلك من قضاء عامَّة ليلها بالتهجّد وقراءة القرآن، وهو ما سنراه في الفصول القادمة من البحث.
وبعد وفاة البتول فاطمة الزهراء‘ تزوَّج أمير المؤمنين× بأمامة بنت أبي العاص[74]، التي كانت من النساء الصالحات اللائي قمنَ بشؤون أولاد فاطمة‘ ومنهم زينب‘[75].
ومع هذه الرعاية فقد كان للإمام علي× الدور الكبير في تربيتها مع إخوتها، فهو المربي الأول الذي وضع أصول التربية ومناهج السلوك، وما قولنا «في رجل تُعزى إليه كلُّ فضيلة، وتنتهي إليه كلُّ فرقة، وتتجاذبه كلُّ طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عذرها، وسابق مضماره، ومجلي حلبتها، كلُّ من بزغ فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى»[76]، ومن كانت فيه هذه الصفات لابدَّ من أن يبذل عناية خاصة في تربية عائلته، ومع ما قدَّمه الأب فإنَّ حنوَّ الإخوة على أختهم لابدَّ من أن يكون كبيراً، فالذي يقرأ سيرة الإمامين الحسن والحسين÷ يجد حسن سيرتهما مع الغريب فكيف بهما مع أختهما وأهل بيتهما؟ وعليه فإنَّنا نستطيع التأكيد على أنَّ أحد مصادر علمها وتربيتها كان أخويها الحسن والحسين÷.
بلغت السيدة زينب‘ مبلغ النساء، ولعلَّ من نافلة القول أنّ حفيدة رسول الله’ سيتقدم لخطبتها الأشراف من رؤساء العرب والقبائل، ولكن أمير المؤمنين قرَّر أن يزوِّجها من ابن أخيه عبد الله بن جعفر(*)بن أبي طالب[77]، على صداق أمِّها فاطمة الزهراء‘ البالغ أربعمائة وثمانين درهماً[78].
وكان عبد الله قد ولد بأرض الحبشة، وهو أول مولود فيها من المسلمين، وكان ممن صحب رسول الله’ وحفظ حديثه[79]، ثم لازم أمير المؤمنين، علياً× ثم الحسن والحسين÷[80].
ونقل عن عبد الله قوله: أنا أحفظ حين دخل الرسول’ على أمي فنعى إليها أبي، فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تذرفان بالدموع وهو يقول، اللهمَّ إنَّ جعفراً قد قدَّم إلى أحسن الثواب فأخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحداً من عبادك في ذريته[81].
أما أمُّ عبد الله فهي أسماء بنت عميس(*)، ولم يذكر المؤرخون السنة التي وُلِد فيها عبد الله، ولكنَّهم ذكروا أنّ الرسول’ توفي ولعبد الله عشر سنين[82]، وعلى ذلك تكون ولادته في السنة الأولى للهجرة، وتزامنت ولادته مع ولادة ابن للنجاشي فسمَّاه عبد الله؛ تيمُّناً باسمه، وأرضعته أسماء بلبن ابنها عبد الله، فهو أخوه بالرضاعة[83].
ولقد بُورِك لعبد الله في رزقه بدعوة رسول الله’ له عند ما رآه وهو يشتري شاة فقال’: اللهمَّ بارك له في صفقته، فقال عبد الله: فما بعت شيئاً ولا اشتريت إلا بُورك لي فيه[84].
وأخبار عبد الله في الكرم كثيرة، ولها شواهد وأمثلة كثيرة في التاريخ؛ منها أنَّ معاوية أهدى إليه حللاً كثيرة وآنية من ذهب وفضة، ووجَّهها إليه مع حاجبه، فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب فقال : هل في نفسك منها شيء؟ فقال: نعم، فضحك عبد الله وقال شأنك بها[85].
وقد وَلَدت السيدة زينب لعبد الله بن جعفر عدَّة أولاد، اختلف المؤرخون في عددهم؛ إذ ذكر بعضهم أنَّهم ثلاثة ذكور وبنت واحدة، وهم علي وعون وعباس وأمُّ كلثوم[86]، ومنهم من أضاف عليهم محمداً[87]، وأضاف بعضهم عليهم بنتاً أخرى[88]، بينما عدَّ النووي أولادها وهم جعفر الأكبر وعلي وعون الأكبر وعباس وأمُّ كلثوم[89]، ويبدو لي أنّ أولادها علي وعون وعباس وأمُّ كلثوم لإجماع الرواة عليهم، وذرية السيدة زينب من علي المعروف بالزينبي[90]، وابنتها أمُّ كلثوم وهي التي خطبها معاوية لابنه يزيد، فزوَّجها الحسين× إلى القاسم بن محمد بن جعفر ابن أبي طالب، وهو ما أثار حفيظة مروان بن الحكم والي معاوية على المدينة، وهو الذي قام بعملية الخطبة[91].
وتوفي عبد الله بن جعفر سنة ثمانين للهجرة، وصلَّى عليه أبان بن عثمان والي المدينة آنذاك[92]، «وعرف ذلك العام بعام العجاف؛ لسيل كان بمكة أحاق بالحاج وذهب بالإبل وعليها الحمولة»[93]، وكان عُمْرُ عبد الله حين وافته المنية تسعين سنة[94].
وقد نُقِل عن عبد الله أنَّه ضاقت يده في السنة التي توفي فيها وهو المعروف عنه الجود والكرم، فصلَّى الجمعة في مسجد رسول الله’، وقال اللهمَّ إنَّك عوَّدتني عادة جريت عليها فإن انقضت مدَّة عادتي فأقبضني إليك، فمات في الجمعة الأخرى[95].
بيَّنا سابقاً أنّ المؤرخين قد أغفلوا مراحل الحياة الأولى للسيدة زينب‘، وبيَّنا أسباب ذلك[96]، إلا أنَّنا يمكن أن نستشفَّ بعض معالم حياتها من خلال بعض المصادر التاريخية، ومن المهمِّ في هذا المجال أن نذكر أنَّ المؤرخين المتأخرين قد تطرقوا إلى بعض الحوادث التاريخية دون أن يذكروا المصادر التي اعتمدوا عليها ونحن نذكرها هنا من غير إشارة إلى المصادر التي لم نوفَّـق إلى العثور عليها، ولم يكن ذكرنا لها إلا على سبيل الأمانة العلمية.
كانت السيدة زينب عاقلة لبيبة جزلة، راجحة العقل قوية الجَنان[97]، وقد أظهرت‘ أنَّها من أكثر آل البيت جرأة وبلاغة وفصاحة، وقد استطارت شهرتها بما أظهرته يوم كربلاء وبعده من حجة وقوة وجرأة وبلاغة[98]، وقُدِّر لهذه السيدة أن تعيش، لتشهد مصرع أبيها علي× وأحداث أخيها الإمام الحسن× وسَمَّه ثم مقتل أخيها الإمام الحسين×، وبذلك لم تتمتع يوماً في حياتها بمباهج الدنيا وزخرفها، ولم تشعر بحياة هادئة مطمئنة[99].
وحازت السيدة زينب من الصفات الحميدة ما لم يحزْهُ بعد أمِّها أحدٌ حتى حقَّ أن يُقال عنها إنَّها الصدِّيقة الصغرى في الحجاب والعفاف لم يَرَ شخصها أحدٌ من الرجال في زمان أبيها وإخوتها حتى يوم الطفِّ، وقد حملت‘ مقداراً من ثقل الإمامة أيام مرض الإمام السجاد علي بن الحسين× بعد أن أوصى إليها الإمام الحسين× بجملة من وصاياه[100].
ويُروَى أنَّه كان لزينب مجلس في بيتها أيام إقامة أبيها أمير المؤمنين في الكوفة، كانت تفسِّر فيه القرآن للنساء[101]، وقيل : إنّها كانت تتلو شيئاًَ من القرآن الكريم بمسمع من أبيها، فبدا لها أن تسأله عن تفسير بعض الآيات، ثم استطرد متأثراً بذكائها اللامع، يلمح إلى ما ينتظرها في مستقبل أيامها، ولشدَّة ما كانت دهشته حين قالت له في جٍدٍّ رصين، أعرف ذلك يا أبي.. أخبرتني به أمي؛ كي تهيئني لغدي[102]، كما يُروَى أنَّ السيدة زينب سألت أباها عن مدى حبِّه لهم فقال× بأنَّه يحبُّهم لأنَّهم ثمرة فؤاده، فقالت: يا أبتِ إنَّ الحبَّ لله تعالى والشفقة لنا[103]، وجلست وهي طفلة في حجر أبيها فقال لها× قولي واحد فقالت: واحد، فقال لها×: قولي اثنين فسكتت، فقال لها تكلَّمي يا بنية، فقالت: يا أبتاه ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد[104].
وقد روت السيدة زينب‘ عن أمِّها فاطمة الزهراء‘، وعن أسماء بنت عميس، وعن أبيها علي×، وأخويها الحسن والحسين÷[105].
وروى عنها محمد بن عمر(*)،وعطاء بن السائب(**)،وفاطمة بنت الحسين(***) وأشهر ما رُوي عنها خطبة والدتها فاطمة الزهراء‘ التي احتجَّت بها بخصوص نِحلتها من أبيها رسول الله’ في فدك عندما مُنِعت من حقِّها فيها[106]، وقد روى هذه الخطبة ابن عباس، عند ما قال: حدَّثتنا عقيلتنا زينب، ثم روى خطبتها تلك[107].
ومن الأخبار المروية عنها‘، عن عطاء بن السائب قول رسول الله’: «إنَّا أهل بيت نُهينا عن الصدقة، وأنَّ موالينا من أنفسنا، ولا نأكل الصدقة»[108].
ورُوي أنَّ الإمام الحسين× أوصى إلى أخته السيدة زينب‘ في الظاهر، وكان ما يخرج عن الإمام علي بن الحسين× من علم ينسب إلى السيدة زينب‘ تستُّراً على الإمام علي بن الحسين×[109].
ومما يُروى عن غزارة علمها وكثرة فقهها، ورجاحة عقلها أنّ الإمامين الحسن والحسين÷جلسا يتذاكران ما سمعاه من جدِّهما رسول الله’: «الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهنَّ كثير من الناس؛ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يقع فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملك حمى ألا وإنَّ حمى الله محارمه، ألا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّه ألا وهي القلب» فقالت اسمعا يا حسن ويا حسين إنَّ جدَّكما رسول الله’ مؤدَّب بأدب الله، فإنَّ الله أدَّبه فأحسن تأديبه[110].
إنَّ هذه الأخبار التي نقلناها على ندرتها وقلَّتها نستطيع أن نستدلَّ من خلالها على أنَّ السيدة زينب× كانت تروي عن جدِّها رسول الله’، رغم صغر سنِّها، كما أنَّها تثبت لنا أنّ السيدة زينب‘ كانت تعيش في وسط يتسم بالعلم والمعرفة وكانت هي جزء من ذلك الوسط، تتحرك من خلاله، تناقش وتعطي الآراء وتشارك في نقل الأحاديث، وتفسير القرآن ورواية الأخبار، وفي كلِّ ذلك كانت تعيش في رعاية أمِّها وأبيها وأخويها الحسن والحسين^، وبعد استشهاد الإمام الحسين× كانت على علاقة صميمة مع ابن أخيها السجاد×.
وعلى الرغم من ندرة النصوص المتقدِّمة التي تتناول حياة السيدة زينب ـ كما أشرنا ـ فإنَّنا نجد بين طيات الكتب رواية هنا ورواية هناك، تعيننا في ترصين ما نذكره، وفي هذا السياق أنقل رواية واحدة من عشرات الروايات التي تناقلها الكتَّاب بتفاصيلها.
«رُوي أنَّ الإمام علي بن الحسين× سأل أحد أصحابه ويُدعى زائدة،فقال له يا زائدة إنَّك تزور قبر أبي عبد الله الحسين× أحياناً، فقال: إنَّ ذلك لكما بلغك،فقال له فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عند سلطانك الذي لا يحتمل أحداً على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا؟ فقال: ما أريد بذلك إلا الله ورسوله ولا أحفل بسخط من سخط ولا يكبر في صدري مكروه ينالني بسببه، فقال : والله إنَّ ذلك لكذلك يقولها ثلاثاً، وأقولها ثلاثاً، فقال له أبشر ثم أبشر، فلأخبرنَّك بخبر كان عندي في النخب المخزون فإنَّه لما أصابنا بالطفِّ ما أصابنا وقتل أبي× وقتل من كان معه من ولده وأخوته وسائر أهله، وحُملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفة فجعلت أنظر إليهم صرعى ولم يواروا، فعظم ذلك في صدري، واشتدَّ لما أرى منهم قلقي، فكادت نفسي تخرج، وتبيَّنتْ ذلك منِّي عمَّتي زينب الكبرى بنت علي‘ فقالت: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وأخوتي، فقلت : وكيف لا أجزع وقد أرى سيدي وأخوتي وعمومتي وولد عمي بدمائهم مرمَّلين بالعرى مسلَّبين لا يكفَّنون ولا يوارون ولا يُعرِّج عليهم أحدٌ، ولا يقربهم بشرٌ كأنَّهم أهل بيت من الدَّيلم والخزر، فقالت: لايجزعنَّك ما ترى فوالله إنَّ ذلك لعهد من رسول الله’ إلى جدِّك وأبيك وعمِّك، ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة، وهم معروفون في أهل السموات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرِّقة فيوارونها، وهذه الجسوم المضرَّجة وينصبون لهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يُدرَس أثرُه ولا يعفو رسمُه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدنَّ أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهوراً وأمره إلا علواً، فقلت: وما هذا العهد؟ وما هذا الخبر؟ فقالت: نعم حدثتني أمُّ أيمن(*)أنّ رسول الله’ زار منزل فاطمة‘ في يوم من الأيام، فعملت له حريرة وأتاه علي× بطبق فيه تمر، ثم قالت أمُّ أيمن: فأتيتهم بعُسٍّ فيه لبن وزبد فأكل رسول الله’ وعلي وفاطمة والحسن والحسين^ من تلك الحريرة، ثم أكلوا من ذلك التمر والزبد، ثم غسل رسول الله’ يده، وعلي× يصبُّ عليه الماء، فلما فرغ من غسل يديه مسح وجهه، ثم نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسين^ نظراً عرفنا به السرور في وجهه، ثم رمق بطرفه نحو السماء ثم وجَّه وجهه نحو القبلة وبسط يديه، ثم خرَّ ساجداً وهو ينشج، فأطال النشوج وعلا نحيبه وجرت دموعه، ثم رفع رأسه وأطرق إلى الأرض ودموعه تقطر، فحزنت فاطمة وعلي والحسن والحسين^ وحزنتُ معهم، وهِبْنا أن نسأله حتى إذا طال ذلك قال له علي× وقالت له فاطمة‘ : ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال’ : سُرِرتُ بكم وإني لأنظر إليكم وأحمد الله على نعمته، إذ هبط جبرائيل× فقال : يا محمد إنَّ الله تبارك وتعالى اطَّلع على ما في نفسك، وعرف سرورك بأخيك وابنتك وسبطيك فأكمل لك النعمة فجعلهم وذريتهم ومحبيهم معك في الجنة، يحبون كما تحبُّ ويعطون كما تعطى حتى ترضى وفوق الرضا، بلوى كثيرة تنالهم في الدنيا بأيدي أناس ينتحلون ملَّتك، ويزعمون أنَّهم من أمتك، براء من الله ومنك، ثم قال جبرائيل : يا محمد، إنَّ أخاك مضطهَد بعدك، مغلوب على أمتك، متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك، يقتله أشرُّ الخلق والخليقة ببلد تكون إليها هجرته،وهو مغرس شيعته وشيعة ولده، وفيه يكثر بلواهم، وإنَّ سبطك هذا، وأومى بيده إلى الإمام الحسين× مقتول في عصابة من ذريتك وأهل بيتك، بأرض يُقال لها كربلاء من أجلها يكثر الكرب والبلاء على أعدائك وأعداء ذريتك، وهي أطيب بقاع الأرض وأعظمها حرمة؛ يُقتل فيها سبطك وأهله، وإنَّها من بطحاء الجنة،فإذا كان اليوم الذي يُقتل فيه سبطك وأهله غضبت السماء والأرض والجبال والبحار ومن فيها، واستأذنوا الله عز وجل في نصرة أهلك المستضعفين المظلومين، فيوحى الله إلى السموات والأرض والجبال والبحار ومن فيهنَّ: أني أنا الله الملك القادر الذي لا يفوته هارب ولا يعجزه ممتنع، وأنا أقدر فيه على الإنتقام، وعزتي وجلالي لأعذبنَّ من وَتَر رسولي وقتل عشيرته، فعند ذلك يضجُّ كلُّ شيء في السموات والأرض، فإذا برزت تلك العصابة إلى مضاجعها تولَّى الله عز وجل قبض أرواحها بيده، وهبط إلى الأرض ملائكة من السماء السابعة معهم آنية من الياقوت والزمرد مملوءة من ماء الحياة، وطيب من طيب الجنة، فغسَّلوا جثثهم بذلك الماء، وصلَّوا عليهم صفاً صفاً، ثم يبعث الله قوماً من أمتك لا يعرفهم الكفار، ولم يشاركوا في تلك الدماء بقولٍ أو فعلٍ فيوارون أجسامهم، ويقيمون رسماً لقبر سيد الشهداء، وسيجتهدُ أناس ممن حقَّت عليهم اللعنة من الله أن يعفوا رسم ذلك القبر ويمحوا أثره، فلا يجعل الله تعالى لهم إلى ذلك سبيلاً، ثم قال رسول الله’ : هذا أبكاني وأحزنني.
قالت زينب‘: فلما ضرب ابن ملجم لعنه الله أبي× ورأيت أثر الموت منه فقلت له : يا أبة حدثتْني أمُّ أيمن بكذا وكذا، وقد أحببت أن اسمعه منك، فقال: يا بنية الحديث كما حدثتْك أمُّ أيمن؛ كأنني بك وبنساء أهلك سبايا بهذا البلد أذلاء خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس، فصبراً صبراً فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما على ظهر الأرض وليٌّ غيركم وغير محبيكم وشيعتكم، ولقد قال لنا رسول الله’ حين أخبرنا أنّ إبليس لعنه الله في ذلك اليوم يطير فرحاً، فيجول الأرض بشياطينه وعفاريته، فيقول يا معشر الشياطين قد أدركنا من ذرية آدم الطَّلِبة،وبلغنا في هلاكهم، ولقد صدَّق عليهم إبليس، وهو كذوب، أنَّه لا ينفع مع عداوتكم عمل صالح، ولا يضرُّ مع محبتكم وموالاتكم ذنب غير الكبائر[111].
الفصل الثاني
دورها‘ في أحداث عصرها من المدينة إلى الكوفة
المبحث الأول: دورها من المدينة المنورة إلى كربلاء
المبحث الثاني: زينب وأحداث معركة الطف
المبحث الثالث: السيدة زينب‘ بعد استشهاد الإمام الحسين×
المبحث الرابع: السبايا في الكوفة
بعد استشهاد الإمام علي× سنة 41هـ، [112] تولَّى معاوية بن أبي سفيان(*)، حكم الدولة الإسلامية التي عرفت بالدولة الأموية حتى سنة 50 هـ، وهي السنة التي استُشهد فيها الإمام الحسن×[113] لم يجرؤ معاوية أنّ يتحدث بموضوع ولاية العهد أو فيمَنْ يخلفه، وقد أعطى العهود والمواثيق للإمام الحسن× «ثم لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن& إلا يسيرا حتى بايع ليزيد بالشام»[114]، ومنذ تلك السنة أخذ معاوية يوطِّد الأرض ويهيئ النفوس لبيعة يزيد، إذ «لم يزل يروِّض الناس لبيعته سبع سنين، ويشاور، ويعطي الأقارب ويداني الأبعاد، حتى استوثق له من أكثر الناس»[115]، وحتى احسّ بدنوِّ منيته، أرسل إلى ابنه يزيد ـ وكان غائبا عن دمشق ـ فلما أبطأ عليه جمع خاصّته وقال لهم : «أبلغا يزيد وصيتي وأعلماه أني آمره في أهل الحجاز، أن يكرم من قدم عليه منهم، ويتعهد من غاب عنه من أشرافهم؛ فإنَّهم أصله، وأني آمره في أهل العراق أن يرفق بهم، ويداريهم ويتجاوز عن زلاتهم، وأنَّي آمره في أهل الشام أن يجعلهم عينته وباطنته، وألا يطيل حبسهم في غير شامهم؛ لئلا يجروا على أخلاق غيرهم»[116]، ثم بيَّن أنـّه لا يخاف على يزيد إلا من ثلاثة، هم الحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر[117]، وزاد مؤرخون آخرون عبد الرحمن بن أبي بكر[118]، وقال معاوية يوصي ابنه في أولئك النفر، ففي الحسين× قال: أرجو أن يكفيكه الله، فإنَّه قتل أباه وخذل أخاه[119]، وفي رواية أخرى :إنَّ الحسين× رجل خفيف لن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه، فإن خرج وظفرتَ به فاصفح عنه[120]، وأما ابن الزبير فإنَّه ضبٌّ خبّ، وإن ظفرت به فقطّعه إرباً إرباً، وأما ابن عمر فإنه رجل مشغول بالعبادة[121]، وأما ابن أبي بكر فليس له من النباهة والذكر عند الناس ما يمكِّن من طلبها[122]، ليس له همة إلا في النساء واللهو[123].
وهكذا مات معاوية وقد رسم طريق الحكم وإدارة الدولة لولده يزيد، وذلك في سنة 60 هـ[124]، ليجلس ابنه مكانه في سابقة لم يعرفها تاريخ الدولة الإسلامية ونقصد به (ولاية العهد)، وفي أول خطبة له بعد توليته الحكم نعا يزيدُ أباه، ثم قال «وقد وُلِّيت الأمر بعده، ولست اعتذر من جهل، ولا أشتغل بطلب علم»[125].
وكتب يزيد إلى ولاته في الأمصار يخبرهم بموت معاوية، ويطلب منهم أخذ البيعة له من الناس[126]، «وكان والي المدينة المنورة آنذاك الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فكتب إليه أن احضر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير، وخذهما بالبيعة أخذاً شديداً، ومَن لم يبايع فأنفذ برأسه مع جواب الكتاب»[127].
قرأ الوليد الكتاب وبعث إلى مروان بن الحكم(*)، فأحضره وقرأ عليه الكتاب واستشاره في أخذ البيعة من أولئك النفر، فأشار مروان بإحضارهم في الحال وأخذ البيعة منهم، أو ضرب أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية، فإنَّهم إن علموا بموته وثب كلُّ رجل منهم بناحية، وأظهر الخلاف ودعا إلى نفسه[128]، وبناء على تلك المشورة أرسل الوليد إلى الإمام الحسين× وابن الزبير، فقرأ مروان كتاب يزيد عليه ودعاه إلى البيعة، فقال له الإمام الحسين×: «أما البيعة فإنَّ مثلي لا يبايع سرَّاً ولا يجتزى بها مني سرَّاً، فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم للبيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحدا»[129]، فأذن له الوليد بالإنصراف، فقال مروان : والله إن خرج لم ترَه، فخذه بأن يبايع وإلا فاضرب عنقه[130]، فوبَّخه الإمام الحسين× ثم أقبل على الوليد وقال : «أيُّها الأمير! إنَّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة ومحلُّ الرحمة، وبنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق، شارب خمر، قاتل النفس المحرَّمة، مُعلِن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون أينا أحقُّ بالخلافة والبيعة»[131].
سار الحسين× من ليلته باتجاه مكة، وأخذ معه بنيه وأخوته وبني أخيه وجلَّ أهل بيته، إلا محمد بن الحنفية، الذي نصحه بالمسير إلى مكة[132]، أو الذهاب إلى اليمن؛ لأنَّ فيها كثيراً من الأنصار، وفي تلك اللحظات كتب الإمام الحسين× وصيته إلى أخيه محمد التي جاء فيها «إنِّي لم اخرج أَشِراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالما، وإنَّما خرجت لطلب النجاح والصلاح في أُمَّة جدِّي محمد’، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر»[133].
ويبدو أنَّ إصرار الإمام الحسين× في عدم البقاء في المدينة على الرغم من أنّ له ثقلاً كبيراً بين رجالاتها، فهي مدينة جدِّه رسول الله’، وأصحابه الذين يعرفون حقَّه ومكانته موجودون ويمنعونه عند الحاجة، إلا أنه رفض أن تنتهك حرمة مدينة جدِّه، وهي حرم آمن بدليل قول الرسول’«اللهم إنَّ إبراهيم خليلك ونبيك وانَّك حرَّمت مكة على لسان إبراهيم، اللهم وأنا عبدك ونبيك، وإنِّي أُحرِّم مابين لابتيها»[134]أو قوله |: «اللهم إنَّ إبراهيم حرَّم مكة، وأنا أُحرِّم ما بين لابتيها»[135]، ولا يخفى على أيِّ متأمِّل احتمال وقوع مواجهة عسكرية بين الجيش الأموي وبين الإمام الحسين× وأنصاره، مما يؤدي إلى انتهاك حرمة المدينة الآمنة، فضلاً عما يسعى إليه الأمويون وأنصارهم إلى محاولة اغتيال الإمام الحسين× في المدينة، وبصورة غامضة تظهرهم بمظهر الأبرياء من دمه، وقد يمثِّلون دور المطالب بدمه؛ للتقرب إلى قلوب الأمة.
سار الإمام الحسين× بركبه نحو مكة وهو يقرأ: (فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)[136]، تاركاً خلفه أخاه محمد بن الحنفية، وبعضاً من أهل بيته، وعلى مايبدوأنَّ الإمام الحسين× أراد أن يفوِّت الفرصة على الأمويين في استئصال شأفة آل بيته؛ لذلك كان من الواجب بقاء شخصيات على مستوى رفيع من قوة الشخصية والمكانة الاجتماعية، رجالاً ونساءً يمكن لهم المحافظة على المبادئ التي خرج من أجلها الإمام الحسين×، فكان من بين النساء أمُّ سلمة زوجة الرسول’(*)، وأُمُّ هانئ أخت الإمام علي×(**)، وأُمُّ البنين(***) زوجة الإمام علي×، أمَّا بقاء محمد بن الحنفية فقد علّله الإمام الحسين× بنفسه عندما قال لأخيه : «وأمَّا أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم بالمدينة؛ فتكون لي عينا عليهم ولا تُخفِ عليَّ شيئا من أمورهم»[137].
وقد يسأل سائل فيقول: ما سبب حمل الإمام الحسين× النساء والصبيان معه في خروجه من المدينة؟ وجوابنا على ذلك أنّ الإمام الحسين× والصحابة والتابعين كانوا يعلمون بمقتل الإمام الحسين× قبل وقوعه، منذ عهد رسول الله’ وبما تناقله الرواة عن رسول الله’، فقد رُوي أنَّ النبي’ أعطى أمَّ سلمة ترابا من تربة الإمام الحسين× حمله إليه جبرئيل×، فقال النبي’ لأمِّ سلمة: إذا صار هذا التراب دماً فقد قتل الإمام الحسين×، فحفظته أمُّ سلمة في قارورة عندها، فلما قُتل الإمام الحسين× صار التراب دماً، فأعلمت الناس بقتله[138]، وعن رسول الله’ قوله «يُقتل الحسين بن علي على رأس ستين من مهاجرتي»[139]، أو قوله’، وهو يشير إلى الإمام الحسين× «أخبرني جبرئيل× أنَّ هذا يُقتَل بأرض العراق»[140]، أو قوله’ لأصحابه : إنَّ الإمام الحسين× سيرتحل عن المدينة إلى «أرض مقتله وموضع مصرعه، أرض كرب وبلاء وقتل وفناء، ينصره عصابة من المسلمين، أولئك من سادات شهداء أمتي يوم القيامة»[141]، أو قوله’ وهو يشير إلى الإمام الحسين× «إنَّ ابني هذا يُقتَل بأرض العراق، فمن أدركه فلينصره»[142]، ويبدو أنّ الإمام الحسين× كان يرى أنّ ثورته ونهضته ستكون ناقصة من دون وجود العائلة معه؛ إذ أنَّ أجهزة الدعاية في الدولة الأموية كانت ستنشر براءتها من قتله×، ولكنَّ وجود العائلة معه في كربلاء لم يُبقِ ِ أيَّ مجال لتلك الأجهزة بخاصة أنَّها لم تكتفِ بقتل الإمام الحسين× وإنَّما أضافت إلى ذلك سبيَ النساء والأطفال، فكانت العائلة لا تدخل إلى بلد إلا وتنشر في أهل ذلك البلد زيف أجهزة الدعاية الأموية التي كانت تدَّعِي بأنَّ السبايا من الخوارج، أو عصابة متمرِّدة على الدولة الأموية، وكانت السيدة زينب هي التي تقوم بدور جهاز الدعاية المضادِّ لجهاز الدولة، بل يمكن أن نقول عنها إنـّها قامت مقام دور الإعلام في يومنا هذا، وهي تجوب الأمصار مع السبايا، وتكشف من خلال خطبها زيف الإدِّعاءات الأموية وعلى ذلك فإنَّ اصطحاب العائلة كان على جانب كبير من الحكمة واليقظة والمعرفة وفهم للظروف القادمة، «ولقد رأى المسلمون في السبايا من الفجيعة أكثر مما رأوا من مقتل الإمام الحسين×»[143]، ولولاهنَّ لم يتحقَّق الهدف من قتل الإمام الحسين× وهو انهيار الدولة الأموية بتلك السرعة على الرغم من قوَّتها وقدرتها العسكرية فلقد أصبحت كلُّ الثورات بعد مقتل الإمام الحسين× ترفع شعاراً مركزيا لها هو «يا لثارات الحسين»، وقبل مقتله× لم يكن أحد ليجرأ بالثورة على تلك الدولة، ولكن الثورات توالت بعد ذلك حتى انتهت بسقوط الدولة الأموية عام 132 هـ.
أقام الإمام الحسين× في مكة، فكتب إليه أهل العراق، ووجَّهوا إليه الرسل على إثر الرسل، وكان آخر كتبهم «بسم الله الرحمن الرحيم، للحسين بن علي من شيعته المؤمنين والمسلمين، أمّا بعدُ فحيَّ هَلَا فإنَّ الناس ينتظرونك، لا إمام لهم غيرك، فالعجل ثم العجل»[144]، فوجَّه إليهم ابن عمِّه مسلم بن عقيل(*)، وكتب إليهم وأعلمهم أنَّه إثر كتابهم، فلما قدم مسلم الكوفة اجتمعوا إليه، فبايعوه وعاهدوه وأعطوه المواثيق على النصرة والمشايعة والوفاء[145]، وقُدِّرتْ جموع المبايعين للإمام الحسين× بين (25-40) ألف مبايع[146].
وبقي الإمام الحسين× بمكة لأيام بقين من شعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة[147]، فلما عزم على الخروج بلغ ذلك عبد الله بن عباس، فأقبل حتى دخل على الإمام الحسين×، وحذَّره من الذهاب إلى العراق ولكنَّ الإمام الحسين× أبى إلا المضي إلى هدفه، فقال ابن عباس فإنْ كنت سائراً فلا تَسِرْ بنسائك وصبيتك[148]، وبنفس المقال توجَّه محمد بن الحنفية الذي جاء إلى موسم الحج، وطلب من الإمام الحسين× أن لا يرحل بالنساء والصبية، لكنَّ الإمام الحسين× قال له: «إنَّ الله قد شاء أن يراهنَّ سبايا»[149].
إنَّ تحرُّكَ الإمام الحسين× بهذا الركب كان دليلاً كبيراً على أنَّه لم يكن ليقصد الكوفة ليتولَّى السلطة فيها، ومن ثَمَّ يناهض يزيد ليزيله عن الخلافة، وإنَّ قوله بأنَّ الله شاء أن يراهُنَّ سبايا لدليل آخر على معرفته بالمصير الذي هو ذاهب إليه، ولذلك نراه يقف مخاطبا أصحابه يوم خروجه من مكة قائلا «من كان باذلا فينا مهجته، وموطِّنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا؛ فإنِّي راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى»[150].وأرسل زوج السيدة زينب‘ عبد الله بن جعفر ولديه عوناً ومحمداً برسالة إلى الإمام الحسين× بكتاب يطالبه فيه بعدم الخروج من مكة، ثم لحق هو بالإمام الحسين× وطالبه بعدم الخروج، ولكنَّ الإمام الحسين× اعتذر وقال: إنـّي رأيتُ رسول الله’ في المنام، وأُمِرتُ بأمر أنا ماضٍ به علي أوَّلى، وعندما طلب منه أن يقصَّ الرؤيا، قال الإمام الحسين×: ما حدَّثت بها أحداً، وما أنا محدِّثٌ بها أحداً حتى ألقى ربي[151].
وعرض عبد الله بن الزبير على الإمام الحسين× أن يقيم بمكة؛ فيبايعه ويبايعه الناس، فقال الإمام الحسين×: لأن أُقتَل خارجا من مكة بشبر أحبُّ إليَّ من أن أُقتَل فيها! ولأن أُقتَل خارجا منها بشبرين أحبُّ إليَّ من أن أُقتَل خارجا منها بشبر[152]، ولعلَّ هذا الحديث يدلّ على أنّ الإمام الحسين× كان يعلم بمقتله؛ وإنَّما خرج من مكة لئلا يُقتَل فيها، فيُستَحلَّ بها حرمة الحرم، الذي تواترت بحرمته وأمنه الآيات القرآنية، ومنها قوله تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)[153]، وقوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)[154]، وتواترت الأحاديث النبوية الشريفة بحرمته أيضا، كقول الرسول’ يوم فتح مكة «إنَّ هذا البلد حَرَّمهُ الله، لا يُعضَدُ شوكه، ولا يُنفَّرُ صيده»[155]،و قوله’: «إنَّ مكة حرَّمها الله تعالى ولم يحرِّمْها الناس، ولا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله، واليوم الآخر، أن يسفك فيها دماً، أو يعضد بها شجرة، فإن أحدٌ ترخَّص بقتال رسول الله’ فيها، فقولوا له: إنَّ الله أذن لرسوله’ ولم يأذن لك، وإنَّما أُذِن لي فيه ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم، كحرمتها بالأمس، وليبلِّغ الشاهدُ الغائبَ»[156]، وقوله’ في حجة الوداع «إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا»[157].
ولما كثر الذين تحدَّثوا إلى الإمام الحسين× لمنعه من الخروج قال: «والله لا يَدَعُوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلَّط الله عليهم مَن يذلهُّم حتى يكونوا أذلَّ من فرام المرأة»[158]، ثم جمع الإمام الحسين× أصحابه وطاف بالبيت وبالصفا والمروة وتهيأ للخروج، فحمل بناته وأخواته وإخوانه على المحامل[159]، وخرج× من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضينَ من ذي الحجة[160]، فاعترضه صاحب شرطة أميرها، فامتنع الإمام الحسين×، وتدافع الفريقان، واضطربوا بالسياط، وبلغ الأمير ذلك وخاف تفاقم الأمر؛ فأمر صاحب شرطته بالإنصراف[161].
ولمّا علم يزيد بخروج الإمام الحسين× أرسل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة وكان بها مسلم بن عقيل، وقد نزل في دار هانئ بن عروة[162]، وانتهى أمر مسلم وهانئ بالقتل، وتمَّ سحب جثتيهما بالحبال من الأرجل في الأسواق[163]، ووصل خبر مقتل مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين× وهو خارج من مكة في طريقه إلى العراق بمكان يسمى القطقطانة(*)،وروي أنّه× لما نزل الخزيمية(**)،أقام بها يوما وليلة، فلما أصبح أقبلت أخته السيدة زينب‘ وقالت: يا أخي سمعت هاتفا يقول:
|
ألا يا عينُ فاحتفلي بجهدٍ |
فقال لها الإمام الحسين×: يا أختاه كلُّ الذي قضي فهو كائن[164]، وكان قد صحب الإمام الحسين× قوم من منازل الطريق، فلما سمعوا خبر مسلم، وكانوا قد ظنُّوا أنَّه يقدم على أنصار وعضد تفرقوا عنه، ولم يبقَ معه إلا خاصَّتُه[165].
وأقبل الإمام الحسين× حتى نزل بفلاة بات فيها[166]، ثم ارتحل بعد أن أمر فتيانه بالتزوِّد بالماء[167]، ثم سار منها حتى وصل القادسية(***)، وإذا بالحرِّ بن يزيد الرياحي في ألف فارس من أصحاب عبيد الله بن زياد شاكِّين السلاح، لا يُرى منهم إلا حماليق الحدق[168]، وكان الحصين بن تميم قد قدَّمه بين يديه، فظلَّ ملازماً الإمام الحسين×[169]، فقال له الإمام الحسين×: ألنا أم علينا؟ فقال: بل عليك يا أبا عبد الله، فتياسر الإمام الحسين× عن الطريق ولازمه الحرُّ[170]، حتى وصلا إلى عُذيب الهجانات(*).
فورد كتاب عبيد الله بن زياد على الحرِّ يأمره بالتضييق عليه، وكلما أراد الإمام الحسين× المسير يمنعونه تارة ويسايرونه أخرى حتى بلغ كربلاء (**) في اليوم الثاني من محرم، فقال ما اسم هذه الأرض، فقيل له كربلاء، فقال: اللهمَّ أعوذ بك من الكرب والبلاء، ثم قال: هذا موضع كرب وبلاء انزلوا ههنا والله محطُّ رحالنا ومَسفك دمائنا، وهاهنا محلُّ قبورنا، وههنا والله محلُّ سبي حريمنا، بهذا حدَّثني جدِّي رسول الله’[171]، فلما كان اليوم الثاني لنزوله كربلاء وافاه عمر بن سعد في أربعة آلاف فارس[172].
وصل الركب الحسيني إلى كربلاء في اليوم الثاني من محرم، فنزلوا جميعاً ونزل الحرُّ بن يزيد الرياحي وأصحابه، [173] حتى قدوم عمر بن سعد، ودخل الطرفان في مفاوضات ولقاءات ومكاتبات، حتى يوم التاسع من المحرم[174]، يقول الإمام على ابن الحسين^: إني لجالس تلك العشية التي قتل فيها أبي في صبيحتها وعندي عمتي زينب تمرضني، إذ اعتزل أبي في خباء له، وعنده بعض أصحابه وهم يصلحون السيوف، ويعدُّون العدَّة للقتال، فتمثَّل أبي يقول:
|
يا دهرُ أُفٍ لك من خليلِ |
فأعادها مرَّتين أو ثلاث مرَّات حتى حفظتها وفهمت ما أراد، فخنقتني العبرة فرددتها ولزمت السكون، وعلمت أنَّ البلاء قد نزل، وأمَّا عمَّتي فإنَّها سمعتْ ما سمعتُ، ومن شأن النساء الرقَّة والجزع، فلم تملك نفسها أن وثبت تجرُّ ثوبها وإنَّها لحاسرة حتى انتهت إليه، وقالت: وا ثكلاه، ليت الموت أعدمني الحياة، اليوم ماتتْ أُمِّي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن، يا خليفة الماضين وثمال الباقين، فنظر الإمام الحسين× إليها وقال: يا أخيةُ لا يذهبنَّ بحلمك الشيطان، وترقرقت عيناه بالدموع، وقال لو تُرِك القَطَا لَنام ليلاً[175].
إنَّ الأبيات التي تمثَّل بها الإمام الحسين× تصرِّح بخطر الموت الذي خيّم على الإمام الحسين× وركبه، ولذلك ترى السيدة زينب‘ بأنَّها قد أحسَّت بأنَّ أخاها في خطر، وهو الإحساس نفسه الذي أحسَّه الإمام على بن الحسين× الذي أيقن بنزول البلاء عند سماع ما قاله أبوه، وهو ما نراه جليَّا في استكمال الرواية، إذ إنَّ السيدة زينب‘ أكملت حديثها مع أخيها الإمام الحسين× فقالت: أفتغتصب نفسك اغتصابا؟ فذاك أقرح لقلبي، وأشدُّ على نفسي، ثم لطمت وجهها وهوت إلى جيبها فشقَّته[176] وخرَّت مغشياً عليها، فصبَّ الإمام الحسين× الماء على وجهها فلما أفاقت قال لها: يا أختاه، اتقي الله وتعزَّي بعزاء الله، واعلمي أنَّ أهل الأرض يموتون، وأهل السماء لا يبقون، وأنَّ كلَّ شيء هالك إلا وجه الله، وأخذ يصبِّرها بهذا ونحوه، ثم أوصاها بأنَّه إذا عاجلته المنية بأن لا تشقَّ عليه جيبا، ولا تخمش وجهاً، ولا تدعو بالويل والثبور، ثم خرج إلى أصحابه وأمرهم بأن يدخلوا الإطناب بعضها في بعض، وأن يكونوا بين البيوت ليستقبلوا القوم من وجه واحد وتكون البيوت من ورائهم وعلى أيمانهم وشمائلهم، وبات الإمام الحسين× مع أصحابه طوال الليل يصلُّون ويستغفرون ويتذرَّعون[177].
فالامام الحسين× أراد أن يستجمع قوته العسكرية الصغيرة؛ لتستقبل القوم من جهة واحدة؛ كي لا تتشتَّت قوته وينال منه القوم بسرعة.
وابتدأ الإمام الحسين× القوم بالنصح والإرشاد، علـّهم يعودون عن غيِّهم، ولكن من دون طائل، وفي التاسع من محرم جمع عمر بن سعد(*) عسكره وصفَّهم لصلاة الصبح وصلى بهم، وصلى الإمام الحسين× بأصحابه أيضا، وهم اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا[178]، ثم انصرف فصفَّهم وجعل على الميمنة زهير بن القين(**)، وعلى الميسرة حبيب بن مظاهر(***)، وأعطى رايته لأخيه العباس، وجعل البيوت وراء ظهره، ثم حفر خندقاً وراء البيوت قذف فيه الحطب والخشب وأشعل فيه النار، فناداه شمر بن ذي الجوشن(*)، من معسكر عمر بن سعد: يا حسين تعجَّلت بالنار قبل يوم القيامة، فأراد مسلم بن عوسجة(**) أن يرميه بسهم فمنعه الإمام الحسين× قائلاً: أكره أن أبدأهم بقتال[179].
أمَّا خيمة العقيلة زينب، فقد نُصِبت أمام خيمة النساء وخلف خيام الرجال، من وراء خيمة أخيها الإمام الحسين×، بحيث تشرف على الخيام جميعا، من حيث ترى خيم النساء، ولا يراها من في خيام الرجال[180].
ودعا الإمام الحسين× براحلته فركبها، وخطب في القوم معرِّفاً بنفسه ونسبه، ومكانته في الإسلام، ومكانته من الرسول الكريم’، ثم نادى أناساً بأسمائهم وسألهم عما كتبوه له وهو في الحجاز، فأنكروا عليه ذلك، عند ذاك قال الإمام الحسين×: يا أيها الناس إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم، فقال له قيس ابن الأشعث(*)، ألا تنزل على حكم بني عمك؟ فقال الإمام الحسين×: «والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقرُّ لهم إقرار العبيد»[181].
ولما رأى الإمام الحسين× حرص القوم على تعجيل القتال وعدم انتفاعهم بالنصائح طلب من أخيه العباس× يكلِّمهم بأن يمهلوهم سواد الليل؛ لأداء الصلاة وتلاوة القرآن، فوافق عمر بن سعد[182].
جلس الإمام الحسين× فرقد ثم استيقظ، فقال لأخته السيدة زينب‘: «إني رأيت الساعة جدِّي محمد’ وأبي عليا وأمي فاطمة وأخي الحسن وهم يقولون: يا حسين إنَّك رائح إلينا عن قريب».
قال الراوي: فلطمت السيدة زينب‘ وجهها وصاحت وبكت، فقال لها الإمام الحسين×: مهلا لا تشمتي القوم بنا[183].
وقيل إنَّ عمر بن سعد زحف نحو خيام الإمام الحسين× بعد العصر من يوم التاسع، وكان الإمام الحسين× جالسا أمام خيمته محتبياً بسيفه؛ إذ خفق برأسه على ركبته فسمعت أخته السيدة زينب‘ الضجَّة، فدنت من أخيها فقالت: يا أخي أما تسمع الأصوات قد اقتربت؟ فرفع الإمام الحسين× رأسه فقال: إنيّ رأيت رسول الله’ الساعة في المنام، فقال إنَّك تروح إلينا، فلطمت أخته وجهها ونادت بالويل، فقال لها الإمام الحسين× ليس لك الويل، اسكتي رحمك الله ثم أرسل الإمام الحسين× أخاه العباس وأخذ المهلة من القوم[184].
بعد ذلك اتَّجه الإمام الحسين× إلى أصحابه وقال لهم: إنَّ القوم لا يقصدون غيري وقد قضيتم ما عليكم فانصرفوا فأنتم في حِلٍّ، فقالوا لا والله يا ابن رسول الله’ حتى تكون أنفسنا قبل نفسك، فجزَّاهم خيراً[185].
إنَّ المتتبِّع للتاريخ الإسلامي يجد هذا النوع من المثالية في التعامل مفقودا لدى كلِّ الناس سوى أهل البيت^ الذين يطلبون من الناس أن يفارقوهم في أشدِّ اللحظات وأعتقد أنَّهم كانوا لا يريدون أن يبقى معهم سوى من تأصَّل الإيمان في نفسه.
لقد بالغ الإمام الحسين× وأصحابه في أداء النصح إلى الأعداء عن طريق الخطب والكلام معهم، فكان كلُّ شخص من أصحاب الإمام الحسين× قبل خروجه يعظ القوم وينصحهم ولكن دون جدوى، ولما أحسَّ عمر بن سعد أنَّ التمرُّد سوف يحصل في جيشه اتجه بقوّاته نحو معسكر الإمام الحسين× ورفع صوته قائلا «اشهدوا لي عند الأمير أنـّي أوَّل من رمى الحسين»[186]، بعد ذلك وقعت المعركة وتقدَّم أصحاب الإمام الحسين× الواحد تلو الآخر يقاتل ثم يُقتَل، حتى فنوا عن آخرهم، وقد أبلوا في المعركة بلاءً حسناً من أجل الدفاع عن آل الرسول’.
وبعدما استشهد أصحاب الإمام الحسين× تقدَّم أهل بيته^، وكان من بين المتقدِّمين علي الأكبر ابن الإمام الحسين×، فلما قُتل جاء الإمام الحسين× حتى وقف عليه فقال: «قتل الله قوما قتلوك ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول’، على الدنيا بعدك العفا، وانهملت عيناه بالدموع»[187]، قالوا: وخرجت السيدة زينب‘ أخت الإمام الحسين× تنادي: يا حبيباه وابن أُخيَّاه وجاءت حتى انكبت عليه، فأخذ الإمام الحسين× برأسها فردَّها إلى الفسطاط، وقال لفتيانه: احملوا أخاكم، فحملوه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه[188].
ويبدو أنّ السيدة زينب‘ كانت في يوم عاشوراء تتلقَّى المصائب بقلب راسخ الإيمان، وكانت‘ تلازم الخيام وتحاول عدم الخروج منها؛ لأنَّها بخروجها تثير قلق النساء والأطفال، لكنَّها خرجت‘ عندما رأت أخاها الإمام الحسين× يحمل جسد ابنه وهي تعلم أنَّ الأب مهما كان صبره لا يستطيع أن يرى ابنه بهذا الحال؛ لهذا خرجت تخفـّف عن الحسين× مصابه بابنه، وعندما تركه مع باقي القتلى من أصحابه وأهل بيته أرجعها إلى الخيمة؛ لأنَّه كان غيوراً على حرمه[189].
ومن بين القتلى الذين قتلوا بين يدي الإمام الحسين× أولاد السيدة زينب‘«محمد وعون ابنـَا عبد الله بن جعفر»[190]، اللذان أمرهما أبوهما بلزوم خالهما الإمام الحسين× والمسير معه، فلحقا بالإمام الحسين× وهو خارج مكة.
وقيل : إنَّه لما اشتدَّت الحرب أخذت السيدة زينب‘ بيدي محمد وعون وتقدَّمت بهما إلى أخيها الإمام الحسين× وقالت له: جدي إبراهيم× قبل الأضحية من قبل الله عزَّ وجلَّ، فاقبل منِّي هذين الولدين ليقدما أنفسهما في سبيلك ولو لم يسقط الجهاد عن المرأة لفديتك بنفسي ألف مرة، فأذن الإمام الحسين× لهما وبعد استشهادهما حملهما الإمام الحسين×، وجاء بهما إلى الخيمة، فخرجت نساء بني هاشم إلا العقيلة زينب‘ أبت أن تخرج؛ وذلك لكي لا يراها أخوها الإمام الحسين× في حال من البكاء والجزع، فيخجل منها ولا يجد لذلك جواباً[191].
وقيل: إنَّ من الثابت أنّ مصيبة ولديها أوجدت في قلبها الحزن العميق، بل وألهبت في نفسها نيران الأسى، ومرارة الثكل، ولكنَّها‘ كانت تخفي حزنها على أولادها؛ لأنَّ جميع عواطفها كانت متجهة نحو الإمام الحسين×[192].
ولما رأى الإمام الحسين× نفسه وحيدا في الميدان قرَّر الخروج لملاقاة الأعداء فاتجه لتوديع النساء والأطفال، فدخل على الإمام علي بن الحسين^ وكانت عنده عمَّتُه السيدة زينب‘ تمرِّضه، فأخذ يسأل أباه عن أخوته وأصحابه فقال له الإمام الحسين×: يا بنيَّ اعلم أنَّه ليس في الخيام رجل إلا أنا وأنت، وأمَّا هؤلاء الذين تسأل عنهم فكلُّهم صرعى على وجه الثرى[193]، فالتفت إلى عمته السيدة زينب‘، فقال لها: علي بالعصا والسيف، فقال له الإمام الحسين× ما تصنع بهما؟ فقال: أمَّا العصا فأتوكَّأ عليها، وأمَّا السيف فأذبُّ به عن ابن رسول الله’ وكانت الأمراض قد ألمَّت به فنهاه الإمام الحسين× وأمسكته عمته السيدة زينب‘[194].
وتوالت المصائب على السيدة زينب‘، وكان من أشدِّها على نفسها مقتل أخيها العباس× الذي كان حامل اللواء في المعركة، فوقفت مذهولة وهي ترى أخاها الحسين× يأذن بوقوع البلاء بعد فقد أخيه بقوله: واضيعتنا بعدك[195]، ولما رأى الإمام الحسين× مصارع أبنائه وأحبته عزم على لقاء القوم، فناداهم بقوله: «هل من ذابٍّ يذبُّ عن حرم رسول الله’؟ هل من موحِّد يخاف الله فينا؟ هل من معين يرجو الله بإغاثتنا؟ »[196]، في إشارة واضحة منه× لإلقاء الحجة على القوم حتى لا يكون له عذر يوم الحساب، ثمَّ طلب طفله الرضيع في تلك اللحظة؛ ليطلب له الماء فرماه حرملة بن كاهل، فذبحه وهو في حجر والده الإمام الحسين×، فأعطاه للسيدة زينب‘ بعد أن رمى بالدم ـ الذي امتلأت به كفاه ـ إلى السماء قائلاً: هوَّن ما نزل بي أنه بعين الله[197].
ثم إنَّ الإمام الحسين× دعا النساء جميعهنَّ وقال لهن: «استعدُّوا للبلاء واعلموا أنَّ الله حافظكم وحاميكم، وسينجيكم من شرِّ الأعداء، ويجعل عاقبة أمركم إلى خير، ويعذِّب أعاديكم بأنواع العذاب، ويعوّضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكُوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص قدركم»[198].
ثم أمرهم بلبس أُزُرِهنَّ ومقانعهن، فسألته السيدة زينب‘ عن سبب ذلك، فقال: كأنَّي أراكم عن قريب كالإماء والعبيد، يسوقونكم أمام الركب ويسومونكم سوء العذاب»، فلما سمعت السيدة زينب‘ ذلك بكت ونادت، واوحدتاه واقلَّة ناصراه[199].
فقال لها الإمام الحسين×: «مهلا يا ابنة المرتضى إنَّ البكاء طويل»[200]، ثم أراد الإمام أن يخرج من الخيمة، فتعلَّقت به السيدة زينب‘، وقالت: «مهلا يا أخي توقَّف حتى أتزوَّد منك ومن نظري إليك، وأودِّعك وداع مفارق ٍ لا تلاقي بعده فجعلت تقبِّل يديه ورجليه، فصبَّرها الإمام الحسين×، وذكر لها ما أعدَّ الله للصابرين»[201]، فقالت: يا ابن أمي طِبْ نفسا وقرَّعيناً فإنَّك تجدني كما تحبُّ وترضى، قال الإمام الحسين×: ابعثوا لي ثوبا لا يرغب فيه أحد؛ أجعله تحت ثيابي لئلا أُجرَّد منه، فأتي بتبَّان، فقال: لها ذلك لباس مَنْ ضُر ِبت عليه الذلَّة، فأخذ ثوبا خَلِقاً فمزَّقه وجعله تحت ثيابه، فلما قُتِل× جرَّدوه منه، ثم استدعى× بسراويل من حبرة ففزرها ولبسها، وإنمَّا فزرها لئلا يُسلَبَها، فلما قُتِل سلبها بحر بن كعب وترك الإمام الحسين× مجرَّداً[202].
ولما قُتِل جميع أصحاب الإمام الحسين× ورجال أهل البيت ولم يبقَ منهم أحد عزم الإمام× على لقاء القوم بنفسه، فدعا ببردة رسول الله’ والتحف بها وأفرغ عليها درعه الشريف، وتقلَّد سيفه وقاتل الأعداء، فصاح عمر بن سعد الويل لكم أتدرون مَنْ تقاتلون؟ هذا ابن الأنزع البطين، هذا ابن قتَّال العرب احملوا عليه من كلِّ جانب، فحملوا عليه[203]، ثم رشقوه بالسهام، ثم إنَّ شمر بن ذي الجوشن أقبل في مجموعة من رجاله نحو خيمة الإمام الحسين× فحالوا بينه وبين رحله، فصاح الإمام الحسين× ويلكم يا شيعة الشيطان إن لم يكن لكم دين، ولا تخافون المعاد فكونوا أحراراً وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم فكفُّوا سفهاءكم وجهالكم عن التعرُّض لحرمي[204]، فقال الشمر لك ذلك يا ابن فاطمة[205]، ثم جعل الشمر يحرِّض أصحابه على قتل الإمام الحسين×، وهو يحمل عليهم فينكشفون عنه، ولما أحاطوا به أقبل غلام من عند النساء يشتدُّ حتى وقف إلى جانب عمِّه الإمام الحسين×، فلحقته السيدة زينب‘ لتحبسه فقال لها الإمام الحسين× احبسيه يا أختي، فأبى وامتنع وقال لا أفارق عمي، وفي هذه اللحظة اتجه بحر بن كعب نحو الإمام الحسين× بالسيف فقال له الغلام: ويلك يا ابن الخبيثة، أتقتل عمي؟ فضربه بحر بالسيف فاتقاها الغلام بيده ثم ضمَّه الإمام الحسين× إلى صدره [206].
قال حميد بن مسلم: فو الله ما رأيت مكسورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا ولا أمضى جناناً منه، إن كانت الرجال تشد عليه فيشد عليها بسيفه[207].
بعد ذلك أقبل فرس الإمام الحسين× إلى خيمة النساء وهو يصهل ويضرب برأسه الأرض عند الخيمة فلما نظرت النساء إلى الفرس رفعن أصواتهن بالصراخ والعويل[208]ثم خرجت السيدة زينب‘ وهي تنادي: واأخاه وا سيداه وا أهل بيتاه، ليت السماء أطبقت على الأرض وليت الجبال تدكدكت على السهل[209]، ثم وجهت كلامها إلى عمر بن سعد بن أبي وقاص وقالت: يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه فلم يجبها عمر بشيء، فنادت ويحكم أما فيكم مسلم فلم يجبها أحد بشيء[210].
وقيل انحدرت زينب‘ نحو ساحة المعركة وهي تركض مسرعة فتارة تتعثر بأذيالها وتارة تسقط على وجهها من عظم دهشتها حتى وصلت إلى وسط المعركة فجعلت تنظر يمينا وشمالا فرأت أخاها الإمام الحسين× ملقى على وجه الأرض فطرحت نفسها على جسده الشريف وأخذت تكلم الإمام الحسين× وهو لا يرد عليها لشدة ما لاقاه من الجهد وعندما ألحت عليه بالخطاب والبكاء أجابها بصوت ضعيف زينب كسرت قلبي وزدتيني كربا على كربي فبالله عليك ألا ماسكت وقيل بينما هي في تلك الحالة إذا بسوط يلتوي على كتفها وشمر يطلب منها التنحي عن الإمام الحسين× أو أن يقتلها معه، فاعتنقت السيدة زينب‘ أخاها؛ لتمنع شمراً من الوصول إليه، إلا أنَّ الشمر أبعدها بالقوة وجلس على صدر الإمام الحسين× واحتزَّ رأسه[211]، وعلى الرغم من أنّ هناك عدداً من الروايات التي تقول إنّ شمراً هو الذي احتزَّ رأس الإمام الحسين×، إلا أنَّنا لا نستطيع تصديق الحوار الذي نقله القزويني بين شمر والسيدة زينب‘، خاصة وأنَّ الإمام الحسين× أوصاها بمجموعة من الوصايا؛ منها التزام المخيَّم للمحافظة على عياله؛ ولكي لا تثير مخاوف النساء، ولا أعتقد أنَّ السيدة زينب‘ تخالف أمر أخيها الإمام الحسين×، وفي رواية أخرى أنّ الإمام الحسين× بعد أن أعيته الجراحات لم يَعُدْ يقوى على القتال والنهوض، ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه، ولكنَّهم كان بعضهم يتقي ببعض، فنادى فيهم شمر ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل؟ اقتلوه ثكلتكم أمهاتكم، فحملوا عليه من كلِّ جانب[212]، ثم نزل إليه سنان بن أنس فذبحه واحتزَّ رأسه، ودفعه إلى خولي بن يزيد(*)، وأخذ قطيفته قيس بن الأشعث وأخذ سيفه رجل من دارم[213].
المبحث الثالث
السيدة زينب‘ بعد استشهاد الإمام الحسين×
لما قُتِل الإمام الحسين× مال الناس على ثقله ومتاعه، ونهبوا ما في الخيام فكانت المرأة لَتنازَع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب عليه، فيذهب به منها[214]«وأن المرأة لَتسلب مقنعتها من رأسها، وخاتمها من إصبعها، وقرطها من أذنها، والخلخال من رجلها»[215].
ونقل عن السيدة زينب‘ أنـّها قالت في اليوم الذي أمر ابن سعد بسلبنا ونهبنا كنت واقفة على باب الخيمة، إذ دخل الخيمة رجل أزرق العينين وأخذ جميع ما كان فيها، وجاء إليَّ فأخذ قناعي وقرطين كانا في أذني، وهو مع ذلك يبكي فقلت: لعنك الله هتكتنا، وأنت مع ذلك تبكي، قال: أبكي مما جرى عليكم أهل البيت، قالت السيدة زينب‘ وقد غاظني قوله، فقلت له : قطع الله يديك ورجليك وأحرقك الله بنار الدنيا قبل نار الآخرة، فما مرَّت الأيام حتى ظهر المختار وفعل به ذلك[216].
وعن فاطمة بنت الإمام الحسين^، «قالت: دخل الجند علينا الفسطاط وأنا جارية صغيرة، وفي رجلي خلخالان من ذهب، فجعل يفضُّ الخلخالين من رجلي وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك يا عدوَّ الله؟ فقال: كيف لا أبكي وأنا أسلب ابنة رسول الله’، فقلت: لا تسلبني، قال: أخاف أن يجئ غيري فيأخذه، قالت: ونهبوا ما في الأبنية حتى كانوا ينزعون الملاحف عن ظهورنا»[217].
وروى حميد بن مسلم قال: «رأيت امرأة من بني بكر بن وائل كانت مع زوجها في أصحاب عمر بن سعد، فلما رأت القوم قد اقتحموا على نساء الإمام الحسين× وفسطاطهنَّ وهم يسلبونهنَّ أخذت سيفاً وأقبلت نحو الفسطاط وقالت: يا آل بكر ابن وائل أُتسلَب بنات رسول الله’؟ لا حكم إلا الله، يا لثارات رسول الله’ فأخذها زوجها وردَّها إلى الخيمة»[218].
وقال: بعد سلب النساء انتهينا إلى الإمام علي بن الحسين^، وهو منبسط على فراش، وهو شديد المرض ومع شمر جماعة من الرجال، فقالوا له : ألا تقتل هذا العليل؟ فقلت : سبحان الله أيُقتَل الصبيان؟ إنَّما هذا صبي، فلم أزل حتى دفعتهم عنه، وجاء عمر بن سعد فصاح النساء في وجهه وبكينَ، فقال لأصحابه: لا يدخل أحد منكم بيوت هؤلاء النسوة، ولا تعرضوا لهذا الغلام المريض، وسألته النسوة ليسترجع ما أُخِذ منهنَّ، فقال: من أخذ من متاعهنَّ شيئا فليردَّه، فوالله ما رأيت أحداً منهم ردَّ شيئاً، فوكَّل بالفسطاط وبيوت النساء وعلي بن الحسين حماية إلى مَنْ كانوا معه، وقال: احفظوهم لئلا يخرج منهم أحد ولا تسيئوا إليهم[219].
ويبدو أنَّ شعار يالثارات رسول الله الذي رفعته هذه المرأة من قبيلة بكر كان شعاراً تأريخياً وسياسياً مهمَّاً جداً؛ لأنَّ هذه المرأة أدركت أنَّ المواجهة الحقيقية هي بين الأمويين وبين الإسلام، وكان هذا هو الهدف الذي سعى إليه الإمام الحسين×، وهو إثبات ابتعاد الأمويين عن مبادئ الدين الإسلامي، وأنَّ حركته كانت تصحيحاً لهذا الواقع.
ونعتقد أنّ أقسى ليلة مرَّت على السيدة زينب‘ كانت ليلة الحادي عشر من محرم، ولو قُيِّض لنا أن نتصور المشهد من كلِّ أبعاده لرأينا الإمام الحسين× مجزَّراً مع إخوته وأبنائه وأهل بيته، كالأضاحي في البيداء، وهم على مقربة من مخيم النساء والأطفال، يصاحب ذلك صهيل خيل العسكر، ولهيب النار من مخيم الإمام الحسين×، وما رافق ذلك النهار من سلب ونهب للنساء وفرار الأطفال، وأمام تلك الصورة الرهيبة ابتدأ الدور الفعلي للسيدة زينب‘؛ فأمام هذه السيدة المتحلية بالإيمان والصبر مهمتان رئيستان؛ الأولى : هي الحفاظ على حرم الرسالة وأطفالها، فسارعت‘ إلى جمع من تفرَّق منهم بعد السبي وحرق الخيام، أما المهمة الثانية: فكانت الأشقَّ والأصعب وهي عملية فضح الجرائم التي ارتكبها الأمويون، واستكمال مجريات الثورة الحسينية من خلال دورها الإعلامي كما سنرى في الصفحات اللاحقة.
ووسط كلِّ تلك الأهوال اتجهت السيدة زينب‘ إلى الله عزَّ وجلَّ لتأدية صلاة الشكر بإيمان صحيح كامل لا ينحرف بصاحبه عن طاعة الله ومرضاته، لأنَّها كانت تنظر إلى تلك الأحداث على أنَّها نعمة خصَّ الله بها أهل بيت النبوة من دون الناس أجمعين[220].
وفي اليوم الثاني ارتحل عمر بن سعد بجيشه إلى الكوفة ومعه نساء الحسين وجواريه وعيالات الأصحاب، وكنَّ عشرين امرأة، وسيَّروهنَّ على أقتاب الجمال بغير وطاء كما يُساق سبي الترك والروم، وكان معهنَّ الإمام علي بن الحسين^ وزيد وعمر والحسن المثنى أولاد الإمام الحسن×، وقيل : إنَّ الحسن المثنى بعدما أصيب أخذه أسماء بن خارجة الفزاري؛ لأنَّ أُمَّه كانت فزارية فتركه ابن سعد له، وكان معهم عقبة بن سمعان مولى الرَّباب زوجة الإمام الحسين×[221]
وقد طلبت النسوة أن يمرُّوا بهنَّ على القتلى، فلما نظرنَ إليهم ـ وهم مقطعو الأوصال ـ صحنَ وضربنَ الوجوه، قال الراوي: «فوالله لا أنسى زينب بنت علي تندب الحسين× وتنادي بصوت حزين وقلب كئيب: يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعراء، مرمَّل بالدماء، مقطَّع الأعضاء، وبناتك سبايا، وذريتك مقتَّلة تسفي عليها ريح الصَّبا فأبكت كلَّ عدوٍّ وصديق[222].
ولما وقفت السيدة زينب‘ على جسد الإمام الحسين× ـ وهو جثَّة بلا رأس ـ وضعت يديها بين كتفيه وقد مزَّقته السيوف والرماح، وقالت بكل خشوع وإيمان «اللهم تقبل منا هذا القربان»[223].
أيَّةُ كلمة على قصرها أبلغ من هذه الفقرة القصيرة، الكبيرة بمضمونها؟ فزينب لم تصرخ ولم تبكِ وإنَّما قصدت جسد أخيها؛ لتدعو الله أن يتقبَّل من هذا البيت الطاهر قربان العقيدة وفداء الإيمان . لقد هزَّت هذه المرأة جيش عمر بن سعد وأطارت نشوة النصر من رؤوسهم؛ إذ كان يحسب أنَّ الإمام الحسين× قد انتهى بمقتله، لكن الذي بدامزَّق هذا الظنَّ البعيد عن الواقع، فأيُّ موقف أعظم وأهمُّ من موقف هذه المرأة المثكولة بأخوتها وأبنائها وأهل بيتها[224]؟ ويبدو أنّ السيدة زينب‘ قد بدأت مهمَّتها الشاقَّة بهذه الكلمة، ففي وسط تلك الجموع بدأت بإعلان رسالتها الإعلامية.
وعندما رأت السيدة زينب‘ ابن أخيها الإمام علي بن الحسين× يجود بنفسه عندما رأى جثمان أبيه وجثث أهل بيته وأصحابه منبوذة بالعراء، اتجهت إلى صوبه وقالت له : «مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وإخوتي؟ فوالله إنَّ هذا لَعهدٌ من الله إلى جدِّك وأبيك»[225].
وبذلك استطاعت السيدة زينب‘ تخفيف ألم ابن أخيها× والمحافظة عليه.
بعث عمر بن سعد برأس الإمام الحسين× في اليوم الذي قُتِل فيه مع خولى بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زياد[226]، وأمر برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فقُطِعت، وأسرع بها مع شمر بن ذي الجوشن وقيس ابن الأشعث وعمرو بن الحجاج، فأقبلوا حتى قدموا بها إلى الكوفة، وأقام ابن سعد بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس، ثم رحل بعيال الإمام الحسين×[227]،ولما ارتحل عمر بن سعد خرج قوم من أهل الغاضرية من بني أسد فصلّـوا على الجثث ودفنوها[228].
ولما وصلت السبايا إلى الكوفة عزفت أبواق الجيش وخفقت راياتهم، وكان ذلك منظراً رهيباً تُدمى منه القلوب، وقد وصفه أحد عمال قصر عبيد الله بن زياد[229]،وهو مسلم الجصاص، بقوله: دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة فبينما أنا أجصِّص الأبواب وإذ بالزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، فأقبلتُ على خادم كان يعمل معنا فقلت: مالي أرى الكوفة تضجُّ؟ قال: الساعة أتوا برأس خارجيٍّ، خرج على يزيد بن معاوية، فقلت: من هذا الخارجي؟ فقال الإمام الحسين ابن علي×، فتركت الخادم حتى خرج ولطمت على وجهي حتى خشيت على عينيَّ أن تذهبا، وغسلت يديَّ من الجصِّ وخرجت من ظهر القصر، وأتيت إلى الكناس، فبينما أنا واقف والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس إذ أقبلت نحو أربعين شقّة تحمل على أربعين جمل، فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة^ وإذا بالإمام علي بن الحسين^ على بعير بغير وطاء وأوداجه تشخبُ دماًَ، وهو مع ذلك يبكي ويقول:
|
يا أمة َ السّوء لا سَقياً لربعكمُ |
قال: وصار أهل الكوفة يناولون الأطفال الذين على المحامل بعض التمر والخبز والجوز، فصاحت بهم أمُّ كلثوم وقالت: يا أهل الكوفة إنَّ الصدقة علينا حرام، وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترميها على الأرض، ثم إنَّ أمَّ كلثوم أطلـّت برأسها من المحمل، وقالت لهم: يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحَكَم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضا[230]، فبينما هي تخاطبهم فإذا بضجَّة قد ارتفعت، وإذا هم قد أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس الإمام الحسين× وهو رأس زهري قمري أشبه الخلق برسول الله، اتصل بلحيته الخضاب، ووجهه كدائرة قمر طالع، والريح تلعب به يميناً وشمالاً، فالتفتت السيدة زينب‘ فرأت رأس أخيها، فضربت جبينها بمقدَّم المحمل حتى رأينا الدم يخرج من تحت قناعها ثم أومأت إليه بخرقة كانت في يدها وقالت:
|
يا هلالاً لما استتمَّ كما لا |
لما وصلتْ السبايا إلى الكوفة اجتمع أهلها للنظر إليهنَّ، قال الراوي: فأشرفت امرأة من الكوفيات فقالت: من أيِّ الأسارى أنتنَّ فقلنَ: نحن أسارى آل محمد’، فنزلت المرأة من سطحها، فجمعت لهنَّ ملاءًا وأزُراً ومقانع وأعطتهنَّ فتغطينَ[232].
كان الإمام الحسين× في كلِّ مرحلة من مراحل ثورته يوضِّح للأمة أسبابها، ويكشف لها انحرافات الحكم الأموي، ويؤكِّد المسؤولية الملقاة على كاهل المسلمين للتصدِّي لهذا الجور والظلم، ولقد تصدَّى الإمام الحسين× بنفسه للقيام بالمهمة الإعلامية منذ خروجه من المدينة حتى قبيل شهادته على رمضاء كربلاء، إلا أنَّ حاجة الثورة إلى الإعلام بعد شهادته ستكون أشدَّ وأكبر، خاصة بعد نشوة الإنتصار الظاهري لمعسكر الأمويين الذي سيدفعهم إلى جعل سحق الثورة الحسينية عبرة لمن يفكِّر بمعارضة الدولة الأموية، أو الوقوف أمام أيِّ بغي أو فساد.
لقد سعى الأمويون إلى أن يشيعوا بين الناس أنّ الإمام الحسين× رجل خارجي خرج عن طاعة الخليفة يزيد؛ ليفرِّق كلمة الأمَّة، ويشقَّ عصا الطاعة، وقد سعى الأمويون جاهدين لترسيخ هذه الفكرة في أذهان الناس[233].
وقد كان الإعلام بعد الشهادة أكثر أهمية منه قبلها[234]، ولم يكن هناك أفضل من السيدة زينب‘؛ لتقوم بهذا الدور، وإبراز أهداف نهضة الإمام الحسين× وتعرية الانتهاكات الأموية للمحرمات، وبيان مدى الإساءة لذرية النبي’ بقتل أولاده وأهل بيته، ومن ثَمَّ سبي عياله وانتهاك حرماتهم[235].
دخلت السيدة زينب‘ إلى الكوفة مع النساء والعيال، يحيط بها الجند، وقد خرج الناس للنظر إليهم، وكانوا على جمال بغير وطاء، فأخذت الكوفيات بالبكاء والصراخ، فأومأت السيدة زينب‘ إلى الناس أن اسكتوا، فارتدَّت الأنفاس، وسكنت الأصوات، فقالت وكأنَّها تتحدث بلسان أبيها أمير المؤمنين:
«الحمدُ لله والصلاة على أبي محمد وآله الطيبين الأخيار ..
أمّا بعدُ:
يا أهل الكوفة، يا أهل الختلوالغدر، أتبكون؟ فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الرنَّة، إنَّما مثلكم كمثل التي نقضتّْ غزلها من بعد قوةٍ أنكاثا(*)، ألا وهل فيكم إلا الصَّلفُالنَّطِف؟ والصدر الَّشنِف؟ ومَلَقُ الإماءوغمز ُ الأعداء؟ أو كمرعى على دِمنة؟ أو كفِضَّة على ملحودة؟ ألاساء ما قدَّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون، وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشَنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبداً.
وأنَّى ترحضون؟ قُتل سليل خاتم النبوة، ومعدن الرسالة، وسيد شباب أهل الجنة، وملاذ خيرتكم، ومفزع نازلتكم، ومنار حجتكم، ومَدَرة سُنَّتكم؟
ألاساء ما تزرون، وبعداً لكم وسحقاً، فلقد خاب السعيُ وتبَّت الأيدي، وخسرت الصفقة، وبُؤتم بغضب من الله، وضُرِبت عليكم الذِّلَّةُ والمسكنة.
ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أيَّ كبدٍ لرسول الله فريتم؟ وأيَّ كريمةٍ له أبرزتم؟ وأيَّ دمٍٍٍ له سفكتم؟ وأيَّ حرمةٍ له هتكتم؟
لقد جئتم بها صلعاءَ عنقاءَ، سوداءَ فقماءَ، خرقاءَ شوهاءَ، كطِلاع الأرض وملاء السماء.
أفعجبتم أن مطرت السماء دماً؟ ولَعذابُ الآخرة أخزى وأنتم لا تُنصرون، فلا يستخفنَّكم المهَل؛ فإنَّه لا يَحفِزُه البِدارُ، ولا يخاف فوت الثَّار، وإنَّ ربَّكم لَبالمرصاد»[236].
وعندما أنهت السيدة زينب‘ خطبتها ضجَّ الناس بالبكاء، وبُهِتوا، وظلُّوا في حيرة من أمرهم، لا يعرفون ما يصنعون، واقترب الإمام علي بن الحسين× من السيدة زينب‘ قائلا لها: اسكتي يا عمَّة؛ فأنتِ بحمد الله عالمة غير مُعلَّمة، وفَهِمَةٌ غيرُ مُفَهَّمة[237].ويبدو لي أنّ الإمام السجاد× قد اضطرَّ إلى إسكات عمَّته، بعد ازدياد الهياج بين الناس، وجاء أمر إسكاتها من قبل شرطة ابن زياد، الذين خافوا أن يتطوّر ذلك الهياج إلى ثورة عارمة، فضلاً عن خوفه على عمته من الإنفعالات وما تسبِّبه من آلام وأحزان.
وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أنَّ ابن زياد عندما نظر إلى ذلك الهياج؛ نتيجة خطبة السيدة زينب‘ أمر برفع الرؤوس أمامها؛ فقطعت كلامها ولم تستطع أن تستمرَّ في خطبتها، بل إنَّها ضربت بجبينها مقدَّم المحمل حتى سال الدم من جبهتها[238].
ولا أعتقد أنَّ هذه الرواية تتمتَّع بنصيب عالٍ من المصداقية؛ إذ إنَّ المتتبع لتأريخ السيدة زينب‘ أثناء واقعة الطف أو بعدها ويقرأ سيرتها في تلك اللحظات العصيبة لا يجدها سوى امرأة قوية، وُصِفت على حدّ قول أحدهم : (لم أَرَ خَفِرةً أنطقَ منها )[239]فمن كانت على هذه الصفة لا أعتقد بأنَّها تتصرَّف تلك التصرُّفات فما بالك بأنَّ أخاها الإمام الحسين× منعها في وصيته لها من تلك الأعمال.
إنَّ خطاب السيدة زينب‘ في الكوفة يُعدّ أوَّل تصريح على واقعة الطف بعد حدوثها، يصدر عن أهل البيت^، ولعلَّ أهمية الخطاب تتمثَّل في أنَّه يحمِّل المجتمع الكوفي مسؤولية ماحدث مباشرة، فضلاً عن أنَّ الخطاب كان الجولة الأولى في المعركة الإعلامية التي ستخوضها السيدة زينب‘ مع إعلام السلطة الأموية وتسلِّطها.
لقد حمَّلت السيدة زينب‘ مجتمع الكوفة المسؤولية المباشرة عمَّا حدث للإمام الحسين× وأهل بيته^، والمصير الذي آلت إليه ثورته؛ لأنَّ الكوفيين هم الذين كاتبوا الإمام الحسين×، وألحُّوا عليه بالقدوم إليهم، وبايعوا سفيره مسلم بن عقيل، لكنَّهم في النهاية خذلوا الإمام× وتخلَّوا عن نصرته، واستسلموا لأجل أموال ابن زياد وترغيبه؛ ولذلك وصفتهم السيدة زينب‘ بأنَّهم كالتي نقضت غزلها من بعد قوةٍ أنكاثاً، ثم إنَّ هذه المسؤولية أصبحت مسؤولية مضاعفة؛ إذ أنَّنا لو تتبعنا قتلة الإمام الحسين× وأصحابه، لوجدنا أنَّ أغلبهم من أبناء المجتمع الكوفي، ثم نرى هؤلاء وبعد حدوث تلك المجزرة يقفون موقف المتفرِّج، وهم يرون رأس الإمام الحسين× ورؤوس أصحابه يُطاف بها على أسنَّة الرماح في شوارع الكوفة وسككها، ويرون بأمِّ أعينهم ما يلاقيه عيال الإمام الحسين× من ذلِّ السبي والأسر فيسكتون خانعين، ولم تتحرَّك فيهم غيرتهم الدينية ولا عصبيتهم القبلية.
ولقد ذهب بعض الباحثين إلى تكذيب واقعة مطر السماء دماً بعد مقتل الإمام الحسين×[240]، إلا أنَّ السيدة زينب‘ في خطبتها أكَّدت هذه الحادثة بقولها «أفعجبتم أن مطرت السماء دماً»[241]، كما أكَّدت السيدة زينب‘ على منزلة الإمام الحسين× ومقامه بعد أن سعت السلطة الأموية إلى التقليل من شأن الإمام الحسين×، والإفتراء على شخصيته، والإشاعة على أنَّه خارجي[242]، لذلك ركَّزت السيدة زينب‘ في خطابها على تأكيد منزلة الإمام الحسين× ومقامه فهو «سليل خاتم النبوة، ومعدن الرسالة، وسيد شباب أهل الجنة»[243]، ثم تؤكِّد السيدة زينب‘ على أنَّ هذه الجريمة سوف لن تمرَّ من دون انتقام؛ فعدالة الله سبحانه وتعالى تأبى أن تمرَّ تلك الجريمة من دون عقاب يتناسب مع خطورتها على الأمَّة الإسلامية، وإن لم يكن ذلك العقاب آنياً فإنَّ الله لا يُخاف منه فوت الثأر ﴿وإنَّ ربَّكم لَبالمرصاد﴾[244]، ولعلَّ الإنتقام الإلهي من قتلة الإمام الحسين× ومن ذلك المجتمع المتواطئ معهم جاء سريعاً وقوياً وشديداً؛ إذ إنَّ المتتبع للتأريخ الإسلامي في تلك الحقبة يجد أنَّ القتلة، أو ذاك المجتمع، لم يعرف بعدَ الحادثة أمناً، ولا استقراراً، ولفترة طويلة من الزمن.
ولم تكن السيدة زينب‘ هي الوحيدة التي خطبت في الكوفيين على الرغم من أنـّها كانت الأولى والأكثر تأثيراً، فقد خطبت السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين^، التي استطاعت على صغر سنِّها أن تثير مشاعر الناس الذين ارتفع بكاؤهم ونحيبهم حتى قالوا لها : «حسبُكِ يا ابنة الطاهرين؛ فقد أحرقتِ قلوبنا، وأنضجتِ نحورنا، وأضرمتِ أجوافنا»[245].
كما خطبت أمُّ كلثوم بنت علي بن طالب^، فبكى الناس وانتحبوا ولم يُرَ أكثر باكٍ ولا باكية من ذلك اليوم[246].وخطب الإمام السجاد× حتى قال مَن كان حاضراً «نحن يا ابن رسول الله’ سامعون مطيعون، حافظون لِذِمامكَ، غير زاهدين فيك، ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك يرحمك الله، فإنَّا حرب لحربك، وسِلم لِسِلمك، نبرأ ممن ظلمك وظلمنا»[247].
هذه الخطب التي ألهبتْ حماس الناس، وأزالتْ الغشاوة عن عيون الآخرين، وبيَّنت زيف الإدعاءات الأموية من جهة أخرى، كانت الفتيل الذي أشعل نار المعارضة ضدَّ الدولة الأموية، وابتدأ ذلك الفتيل بانتفاضة عبد الله بن عفيف الأزدي الذي ردَّ على ابن زياد مقولته على رؤوس الأشهاد، كما سنرى في الصفحات اللاحقة من الرسالة، وقاوم شرطة ابن زياد على الرغم من أنَّه كان أعمى وأنَّ مصيره كان القتل والصلب[248].
لما وصل رأس الإمام الحسين× إلى الكوفة وحضر ابن سعد ومعه بنات الإمام الحسين× وأهله إلى قصر الإمارة، جلس ابن زياد وأذن للناس أُذناً عاماً وأمر بإحضار رأس الإمام الحسين× فوُضع بين يديه، وجعل ينظر إليه ويبتسم وفي يده قضيب يضرب به ثناياه، وكان إلى جانبه زيد بن أرقم صاحب رسول الله’ وهو شيخ كبير، فلما رآه يضرب بالقضيب ثناياه قال له: ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله’ عليهما مالا أحصيه، ثم انتحب باكياً، فقال له ابن زياد: أبكى الله عينيك، أتبكي لفتح الله؟ لولا أنَّك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك، فنهض زيد بن أرقم وذهب إلى منزله[249].
وقيل : خرج وهو يقول ملك عبد عبداً فأتخذه تلدا، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم؛ قتلتم ابن فاطمة، وأمَّرتم بن مرجانة حتى يقتل خياركم ويستعبد أشراركم، رضيتم بالذلِّ فبعداً لمن رضي[250].
وأُدخل عيالُ الإمام الحسين× على ابن زياد، فدخلت السيدة زينب‘ أخت الإمام الحسين× في جملتهم متنكِّرة، وعليها ثياب رثَّة، فمضت حتى جلست ناحية من القصر، وحفَّتْ بها إماؤها، فقال ابن زياد : مَن هذه التي انحازت ناحية ومعها نساؤها؟ فلم تجبه السيدة زينب‘، فأعادها ثانية يسأل عنها، فقال له بعض إمائها: هذه السيدة زينب‘ بنت السيدة فاطمة‘ بنت رسول الله’.
فأقبلعليها ابن زياد، فقال لها: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم، فقالت السيدة زينب‘: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد’، وطهرنا من الرجس تطهيراً، إنَّما يُفتَضَحُ الفاسق ويكذبُ الفاجر وهو غيرُنا والحمد لله، فقال ابن زياد: كيف رأيتِ فعل الله بأهل بيتك؟ قالت: كتب الله عليهم القتلَ فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجُّون إليه وتختصمون عنده، فغضب ابن زياد واستشاط، فقال: عمرو بن حريث: أيُّها الأمير إنها امرأة والمرأة لا تُؤاخذ بشيء من منطقها، ولا تُذمُّ على خطأها، فقال لها ابن زياد: قد شفى الله نفسي من طاغيتك، والعصاة من أهل بيتك، فرقَّت السيدة زينب‘ وبكت وقالت له: لعمري لقد قتلتَ كهلي، وأبدتَ أهلي، وقطعتَ فرعي واجتثثتَ أصلي، فإن يشفِكَ هذا فقد شُفِيتَ، فقال لها ابن زياد: هذه سجَّاعة، ولعمري كان أبوها سجَّاعاً شاعراً، فقالت: ماللمرأة والسَّجَاعة إنَّ لي عن السجاعة لَشغلاً ولكنَّ صدري نفث لما قلت[251].
ثم عُرِض عليه الإمام علي بن الحسين× فقال له: من أنت؟ فقال: أنا علي بن الحسين، فقال: أليس قد قتل الله علي بن الحسين؟ فقال الإمام علي بن الحسين×: قد كان لي أخ يُسمَّى علياً قتله الناس؟ فقال ابن زياد: بل الله قتله، فقال الإمام علي ابن الحسين×: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)[252] فغضب ابن زياد وقال: وبك جرأةٌ لجوابي، وفيك بقية للردِّ عليَّ؟ اذهبوا به فاضربوا عنقه، فتعلَّقت به السيدة زينب‘ عمَّتُه وقالت: يا ابن زياد حسبك من دمائنا، واعتنقته وقالت: والله لا أفارقه فإن قتلته فاقتلني معه، فنظر ابن زياد إليها ثم قال: عجباً للرحم، والله إني لأظنَّها ودَّتْ أني قتلتها معه، دعوه فإني أراه لما به[253].
وكان موقف العقيلة زينب‘ الصلب سببا لعدم إقدام ابن زياد على قتل الإمام زين العابدين×، ولذهاب بقية نسل الرسول’ منهم·
ثم قام ابن زياد من محلِّه، وصعد المنبر فقال: الحمد لله الذي أظهر الحقَّ وأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد، وقتل الكذاب بن الكذاب: فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي ـ وكان من شيعة أمير المؤمنين × ـ فقال له: يا عدوَّ الله إنَّ الكذَّاب أنت وأبوك والذي ولَّاك وأبوه، يا ابن مرجانة أتقتل أولاد النبيين وتقوم على المنبر مقام الصديقين؟ فقال ابن زياد عليَّ به، فأخذته الجلاوزة فارتفع شعار الأزد فاجتمع منهم سبعمائة فانتزعوه من الجلاوزة، فلما كان الليل أرسل إليه ابن زياد مَن أخرجه من بيته، فضرب عنقه، وصلبه[254].
ويبدو أنّ هذه الحركة كانت بداية ً لسلسلة من الثورات التي امتدَّت ضدَّ الحكم الأموي، وكان ذلك بتأثير خطاب السيدة زينب‘.
ثم أمر ابن زياد أن يُطاف برأس الإمام الحسين× في سكك الكوفة كلِّها وقبائلها، وبالإمام علي بن الحسين^ وأهله، فحُملوا إلى دار إلى جانب المسجد الأعظم، فقالت السيدة زينب‘ لا يدخلنَّ علينا عربية إلا أمُّ ولدٍ أو مملوكة فإنهنَّ سُبينَ كما سُبِينا[255].
الفصل الثالث
دورها‘في أحداث عصرها
المبحث الأول: من الكوفة إلى بلاد الشام
المبحث الثاني: السيدة زينب‘ في مجلس يزيد
المبحث الثالث: وفاتها ومدفنـها ‘
تناولنا في الفصل السابق كيفية حمل ركب آل البيت^ من كربلاء، والأحداث التي رافقتهم، وسنتناول في هذا الفصل مسيرة الركب من الكوفة إلى بلاد الشام ومن ثم انتقالهم من الشام إلى المدينة، وصولاً إلى وفاة السيدة زينب‘ والروايات العديدة والمختلفة في مكان دفنها‘.
يُستفاد من النصوص التأريخية أنَّ قافلة السبايا لم يكن بقاؤها في الكوفة إلا يومين فقط؛ إذ «إنَّ عبيد الله بن زياد نصب رأس الحسين بالكوفة، فجُعل يُدار به في الكوفة»[256]، ثم إنَّه جمع الرؤوس «في اليوم الثاني وجهزها والسبايا إلى يزيد بن معاوية»[257].
ولو فرضنا صحة هذه الرواية، لبدا لنا أنّ ابن زياد خشي من هياج الرأي العام ضدَّه في الكوفة، خاصَّة بعد الخطب التي خطبها آل الرسول’، وما واجههُ به في مسجد الكوفة من معارضة، كما أنَّه أراد أن يبلِّغ يزيد بالنصر الذي حقَّقه بأسرع وقت ممكن، فكان قراره بعدم إطالة بقائهم في الكوفة.
وهناك رواية أخرى تقول: إنّ السبايا ظلُّوا في الكوفة المدة التي يستغرقها ذهاب البريد وإيابه بين الكوفة ودمشق، إذ أنَّ «آل الإمام الحسين× لما وصلوا الكوفة حبسهم ابن زياد، وأرسل إلى يزيد بالخبر، فبينما هم في الحبس إذ سقط عليهم حجر فيه كتاب مربوط، وفيه: أنَّ البريد سار بأمركم إلى يزيد فيصل يوم كذا ويعود يوم كذا، فإن سمعتم التكبير فأيقنوا بالقتل، وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان، فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة إذا حجرٌ قد أُلقِي وفيه كتاب يقول: أوصوا واعهدوا فقد قارب وصول البريد»[258].
ويبدو من هذه الرواية أنّ ذلك يدلُّ على أنَّ هناك موالين لآل البيت^داخل الجهاز الحاكم، وكان يحرص على سلامتهم، أو إيصال الأخبار إليهم وهم في حبس ابن زياد، ولذلك بعث إليهم بذلك الكتاب.
أما يزيد بن معاوية فإَّنه لما وصل إليه كتاب ابن زياد أرسل إليه يأمره بحمل رأس الإمام الحسين× ورؤوس مَن قُتِل معه، وأمره بأن يعجِّل بإرسال النساء والعيال، فسيَّرهم ابن زياد إلى الشام كما يسيِّر سبايا الكفار، فيتصفَّح وجوههم أهل الأقطار[259]، وقد أُمر بالإمام علي بن الحسين× أن يُغلَّ بغلٍّ إلى عنقه، فلم يكن يكلِّم أحداً من حرَّاسه كلمة حتى بلغوا إلى قصر يزيد[260].
ويُستفاد من هذه الروايات التاريخية أنَّ يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد لم يكتفيا بما حقَّقاه من قتل الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه والتمثيل بجثثهم، بل أرادوا إذلال أهل البيت؛ بحملهم من بلد إلى بلد بتلك الكيفية؛ ليكونوا عبرة لمن تسوِّل له نفسه القيام ضدَّ الدولة الأموية التي لم تتورَّع عن القضاء على الإمام الحسين× بتلك الطريقة، فكيف بِمَن هو أدنى منزلةً من الإمام الحسين وآل بيته^.
ولما قرب الركب من دمشق(*)، طلبت أمُّ كلثوم من شمر بن ذي الجوشن أن يسلك بهم في درب قليل النظَّارة، وأن يضع الرؤوس أمام النساء؛ حتى ينشغل الناس عن النظر إلى السبايا، إلا أنَّ شمراً، زيادة منه في البغي والكفر أمر بأن تُجعل الرؤوس وسط المحامل، وأن يسلك بالركب وسط الناس حتى وقف بهم على درج باب المسجد الجامع، حيث يُقام السبي وينتظر عادة(1) .
وتصف الروايات حال السبايا عند دخولهم دمشق؛ إذ كان يتقدَّم الركب رأس الإمام الحسين× وخلفه النساء على جمال بغير وطاء، وقد أخذ الناس زينتهم ونشروا الرايات، وكأنهم في عيد من أعيادهم(2).
ويبدو أنّ حالة الفرح والسرور السائدة آنذاك في بلاد الشام كانت ناشئة عن الجهل المطبق لعامة الناس عن ماهية هذا السبي، كما أنّ هناك قسما آخر ممن كان يعلم ذلك، ولكنَّه كان ممن باع دينه بدنياه، واشترى رضا المخلوق بمعصية الخالق.
دخل حرم رسول الله’ مدينة دمشق من باب يقال لها باب توما(**)، ثم أتى بهم بناءً على أوامر يزيد الذي «أمر بنساء وبنات الحسين فأقمن بدرجة المسجد حيث توقف الأسارى؛ لينظر الناس إليهم»[261]، وإذا بشيخ قد أقبل حتى دنا منهم وقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم، وأراح الرجال من سطوتكم، وأمكن أمير المؤمنين منكم، فقال له الإمام علي بن الحسين×: يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قال: نعم قرأته، قال: هل قرأت هذه الآية: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)[262]، فقال الشيخ: قد قرأت ذلك، فقال الإمام علي بن الحسين×، فنحن القربى يا شيخ، قال: فهل قرأت في القرآن: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)(2)؟، ثم قال وهل قرأت: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)[263]، فقال الشيخ: قد قرأت ذلك، فقال: نحن أهل البيت الذي خُصصنا بآية الطهارة، فبقى الشيخ ساكناً نادماً على ما تكلَّم به، ثم رفع رأسه إلى السماء، وقال: اللهمَّ إنِّي تائب إليك مما تكلمته، وأبرأ إليك من عدوِّ محمد وآل محمد من الجنِّ والإنس[264].
وقد قيل إنَّ الإمام علي بن الحسين× لم يتكلَّم بكلمة في الطريق من الكوفة إلى الشام، حتى دخوله إلى دمشق[265].
وإنّ الإمام السجاد× كان يخشى طائلة الإغتيال خاصَّة وأن ابن زياد سعى إلى قتله لولا تدخُّل عمته السيدة زينب‘، كما أنَّ للإمام السجاد مهمة أداء الرسالة في أوَّل فرصة يتأمل فيها من وجود نفوس طيبة تستقبل كلامه، وهو مالم يلاحظه طيلة الطريق، ولكنه ما إن وجد ذلك الشامي، ووجد في نفسه البذرة الطيبة، انطلق الإمام× في أداء رسالته.
فمع أنَّ ذاك الشيخ الشامي لم يَرَ علياً ولا أبناءه^، ولكنه فيما يبدو كان على فطرة سليمة، على عكس من قتل الإمام الحسين× وأصحابه، وسبوا عياله والذين كان كثير منهم ممن رأى علياً والحسن والحسين^، ولعلَّ في هذه الرواية إشارة واضحة على سيطرة الجو الإعلامي على مجتمع وبيئةتربَّت في أحضان الفكر الأموي إذا جاز أن نسميه فكراً، فقد أذاع الأمويون بأنَّ المقتول خارجي خرج على أمير المؤمنين يزيد، ولذلك نرى ذلك الشيخ الشامي يحمد الله في بادئ الأمر على نصره بقتل ذاك الخارجي، ولكنَّه بمجرَّد أن سمع كلام الإمام السجاد× استغفر وتاب إلى الله، وهو ما أدَّى بالتالي إلى قتله من قبل يزيد عند وصول الخبر إليه وذلك لإدامة الجهل الإعلامي في الوسط الشامي.
قيل إنَّ ابن زياد جهَّز الإمام علي بن الحسين× ومن كان معه من الحرم ووجَّه بهم إلى يزيد بن معاوية مع زجر بن قيس وشمر بن ذي الجوشن، فسارا بهم حتى قدموا إلى الشام، ودخلوا على يزيد بن معاوية بمدينة دمشق وأُدخل معه رأس الإمام الحسين× فَرُمِي بين يديه، ثم تكلَّم شمر بن ذي الجوشن فقال: «يا أمير المؤمنين ورد علينا هذا يعني الإمام الحسين× في ثمانية عشر رجلاً من أهل بيته وستين رجلاً من أهله ومن شيعته، فسرنا إليهم وسألناهم النزول على حكم أميرنا عبيد الله ابن زياد أو القتال، فاختاروا القتال، فغدونا عليهم عند شروق الشمس وأحطنا بهم من كلِّ جانب، فلما أخذت السيوف مأخذها جعلوا يلوذون لوذان الحمام من الصقور فما كان إلا مقدار جزر جزور، أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم، فهاتيك أجسادهم مجرَّدة، وثيابهم مرمَّلة، وخدودهم معفَّرة تسفي عليها الرياح، زوارهم العقبان ووفودهم الرَّخم»[266].
وقد أجمع أغلب القدماء[267]على أنَّ الذي قال هذا الكلام ليزيد بن معاوية زجر ابن قيس، بينما تفرَّد الدينوري بنسبة هذا الكلام إلى شمر بن ذي الجوشن.
ولما سمع يزيد هذا الكلام قال: قد كنت أرضىمن طاعتكم بدون قتل الحسين، أما لو أنَّي صاحبه لعفوت عنه[268].
وقيل إنَّه دمعت عيناه، وقال: قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، وقال: كذلك عاقبة البغي والعقوق، ثم تمثَّل يزيد:
|
مَن يَذق الحربَ يجدْ طعمَها |
وقد ذكر المؤرخون أنَّ يزيد بعد ما سمع كلام زجر بن قيس تكلَّم بكلمات تدلُّ على كذبه ونفاقه حتى أنَّه دمعت عيناه، وعلى ما يبدو أنَّ هذا الكلام ليس له صحَّة فلو دقَّقنا في الروايات التأريخية نجد أنَّ يزيد هو من أمر بقتل الإمام الحسين× عندما أرسل إلى والي المدينة يطالبه بأخذ البيعة من الحسين بن علي فإن امتنع فاضرب عنقه، يضاف إلى ذلك أنَّه صرَّح في أشعاره وكشف عن دوافعه الخبيثه بقوله : ليت أشياخي ببدرا شهدوا ... وأنَّ ما أظهره من الندامة يرجع إلى خوفه على زوال ملكه؛ لأنَّ وضع المجلس آنذاك أدَّى بيزيد لاتخاذ هذا الموقف؛ خوفاً من سخط الجماهير عليه (كما سنرى في الفصل القادم)، والدليل على ذلك أنَّه لم يعاقب ابن زياد، ولم يعزله عن الإمارة[270].
ونحن نتفق مع هذا الرأي، فالوضع العام كان مضطرباً داخل مجلس يزيد حيث كان يحضره كبار الصحابة ممن شاهدوا رسول الله’.
ولما وضعت الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الإمام الحسين× أخذ ينكت بقضيب في يده على ثنايا الإمام الحسين×، فقام إليه أبو برزة الأسلمي وقال: ويحك يا يزيد أتنكت بقضيبك ثغرالحسين؟ أشهد لقد رأيت النبي يرشف ثناياه وثنايا أخيه الحسن، ويقول أنتما سيدا شباب أهل الجنة، فغضب يزيد وأمر بإخراجه[271]، فقال يحيى بن الحكم أخو مروان بن الحكم وكان جالساً مع يزيد:
|
لَهامٌ بأدنى الطفِّ أدنى قرابة |
فضرب يزيد في صدر يحيى وقال: اسكت[272].
قال الإمام علي بن الحسين×: «لما أدخلنا على يزيد بن معاوية أتوا بحبال وربَّطونا كالأغنام، وكان الحبل في عنقي وعنق أمِّ كلثوم وكتف زينب وسكينة والبنات، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا حتى أوقفونا بين يدي يزيد»[273].
وقيل : إنَّه أدخل ثقل الإمام الحسين× ومن تخلَّف من أهل بيته على يزيد بن معاوية وهم مقرونون بالحبال، فلما وقفوا بين يديه وهم على تلك الحال، قال الإمام علي بن الحسين×:
«ما ظنُّك بجدِّنا رسول الله لو يرانا على مثل هذه الحالة؟ فبكى الحاضرون وأمر يزيد بالحبال فقطعت»[274].
ثم وُضِع رأس الإمام الحسين× بين يدي يزيد، وأجلس النساء خلفه× لئلا ينظرنَ إليه[275]فلما رأينَ الرأس صحن وصاحت نساء يزيد[276]، ثم قالت السيدة زينب‘: «يا يزيد أما تخاف الله ورسوله من قتل الحسين؟ وما كفاك ذلك حتى تستجلب بنات رسول الله’ من العراق إلى الشام؟ وما كفاك حتى تسوقنا إليك كما تساق الإماء على المطايا بغير وطاء؟ وما قتل أخي الحسين سلام الله عليه أحد غيرك يا يزيد، ولولا أمرك ما يقدر ابن مرجانة أن يقتله، لأنه كان أقل عدداً وأذلَّ نفساً أما خشيت من الله بقتله وقد قال رسول الله’ فيه وفي أخيه «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة من الخلق أجمعين»؟ فإن قلت : لا فقد كذبت وإن قلت : نعم فقد خصمتَ نفسك واعترفتَ بسوء فعلك، فقال: ذرية يتبع بعضها بعضاً، وبقى يزيد خجلاً ساكناً»[277].
وإنّ السيدة زينب‘ قالت كلامها في مجلس يزيد الذي كان يحضره أشراف أهل الشام، بحيث أنَّها ركَّزت على انتسابهم إلى الرسول’، وهذا من أجل أن تكسر حاجز الخوف الذي فرضته السلطة على الناس.
ثم تتخذ السيدة زينب الكبرى‘ موقفاً عاطفياً حينما تواجه رأس أخيها الإمام الحسين×، ومع ذلك تؤثّر في المجلس تأثيراً تامَّا بحيث ينقلب المجلس حتى يبكي كلُّ مَن كان حاضراً ويزيد ساكت[278].
ويُنْقل أنَّ «زينب لما رأت رأس الحسين أهوت إلى جيبها فشقَّته ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسيناه، يا حبيب رسول الله، يا بن مكة ومنى، يا بن فاطمة الزهراء سيدة النساء، يا بن بنت المصطفى، فأبكت كلَّ مَن كان حاضراً في المجلس ويزيد ساكت»[279].
ويبدو أنّ في الرواية ضعفاً ظاهراً؛ بدليل الإشارة إلى أنّ السيدة زينب‘ قد شقَّت جيبها، وهو ما يخالف وصية الإمام الحسين× لها في ليلة العاشر من محرم، ونحن لا نعتقد أنَّها تخالف وصية أخيها ولم يرد في أيِّ نصٍّ من النصوص التأريخية أنّ السيدة زينب‘ قد خالفت وصيةً من وصايا الإمام الحسين× بعد استشهاده.
موقف السيدة زينب‘ من المجتمع الشامي
«قالت فاطمة بنت الإمام الحسين÷: فلما جلسنا بين يدي يزيد ورقَّ لنا، قام إليه رجل من الشام أحمر فقال: يا أمير المؤمنين، هب لي هذه الجارية ـ يعنيني ـ وكنت جارية وضيئة، فارتعدتُ وظننتُ أنَّ ذلك جائز لهم، فأخذت بثياب عمتي زينب وكانت تعلم أنّ ذلك لا يكون، فقالت عمتي للشامي: كذبت والله ولؤمت، والله ما ذلك لك ولا له، فغضب يزيد وقال: كذبتِ أنَّ ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت، قالت: والله ما جعل الله لك ذلك إلا أن تخرج من ملَّتنا وتدين بغير ديننا، فاستطار يزيد غضباً وقال: إياي تستقبلين بهذا؟ إنَّما خرج من الدين أبوك وأخوك، قالت زينب: بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلماً، قال: كذبتِ يا عدوَّةَ الله، قالت له: أنت أمير، تشتم ظالما وتقهر بسلطانك، فكأنَّه استحيا وسكت، فعاد الشامي فقال : هب لي هذه الجارية، فقال له يزيد: اغرب وهب الله لك حتفاً قاضياً»[280].
وذكر المؤرخون أنَّ القصة جرت في شأن فاطمة بنت علي، ثم ذكروا موقف السيدة زينب‘[281].
بينما انفرد أبو الفرج الاصفهاني بذكر الخبر في شأن السيدة زينب‘، وذكر أنَّ يزيد قال للإمام علي بن الحسين× ما اسمك؟ فقال علي بن الحسين، قال أو لم يقتل الله علي بن الحسين؟ قال: قد كان لي أخ أكبر اسمه عليٌ فقتلتموه، قال بل الله قتله، قال علي: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)[282]، قال له يزيد: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) [283].فقال علي: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)[284].
فوثب رجل من أهل الشام فقال: دعني أقتله، فألقت السيدة زينب‘ نفسها عليه، فقام رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين هب لي هذه الجارية أتخذها أمة، فقالت السيدة زينب‘: لا ولا كرامة ليس لك ذلك ولا له إلا أن يخرج من دين الله.
فصاح به يزيد: اجلس، فجلس وأقبلت السيدة زينب‘ عليه وقالت: يا يزيد حسبك من دمائنا، وقال الإمام علي بن الحسين× إن كان لك بهؤلاء النسوة رحم وأردت قتلي فابعث معهنَّ أحداً يؤديهنَّ، فرقَّ، وقال لا يؤديهنَّ غيُرك[285].
لقد حقَّقت السيدة زينب الكبرى‘ هدفاً رسالياً أوضحت فيه حقيقة الإمام الحسين×، وكان ذلك بمثابة نصر ساحق على يزيد، وهو في ذروة السلطة فقد أفحمته مرة بعد أخرى، وقد تمكَّنت أن تظهر جهل مدَّعي الخلافة للناس كما كشفت عن عدم فقهه في شؤون الدين؛ فإنَّ نساء المسلمين لا يصحُّ اعتبارهنَّ سبايا في الحروب، ولا يعاملن معاملة السبي، فكيف إن كُنَّ بنات رسول الله’[286]؟
وُضِع رأس الإمام الحسين× بين يدي يزيد في طست من ذهب، ثم دعا بقضيب من خيزران، فجعل ينكت به ثنايا الإمام الحسين×، فوبَّخه أبو برزة الأسلمي قائلاً: أتنكت بقضيبك ثنايا الحسين وثغره؟ ! أشهد لقد رأيت رسول الله’ يرشف ثناياه وثنايا أخيه، أما إنَّك يا يزيد لتجئ يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجئ هذا ومحمد’ شفيعه[287]، واستشهد بقول الرسول’ في الإمامين الحسن والحسين÷ «من أحبَّ الحسن والحسين فقد أحبَّني، ومن أبغضهما فقد أبغضني»[288]، فأغضب قول أبي برزة يزيد فأمر بإخراجه، فأ ُخرج سحباً، وجعل يزيد يتمثَّل بأبيات عبد الله بن الزبعرى وهو يقول[289]:
|
ليتَ أشياخي ببدر شهدوا |
وزاد يزيد فيها بيتا من شعره:
|
لَستُ من عتبةَ إن لم أنتقمْ |
لم تستطع السيدة زينب‘ أن تمتلك نفسها؛ فاندفعت لتقول ليزيد : «صدق الله ورسوله يا يزيد(ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ)[291].
لقد تناول المؤرخون خطبة السيدة زينب‘ على اختلاف مشاربهم وعقائدهم وضمَّنوها كتبهم بتفاوت بسيط في بعض مواردها[292]، وللأهمية التي تتصف بها الخطبة في حياة السيدة زينب‘، ولما ورد فيها من أمور مهمَّة أوردها هنا كاملة ً: «أظننتَ يا يزيد ـ حيث أخذتَ علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تُساق الإماء ـ أنَّ بنا هواناً على الله وبك عليه كرامة؟ وأنَّ ذلك لِعِظـَم ِ خطرك عنده، فشمختَ بأنفكَ، ونظرت في عطفك، جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا، فمهلاً مهلاً أنسيتَ قول الله: (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)[293]، أمِنَ العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله’ سبايا؟ قد هتكتَ ستورهنَّ، وأبديتَ وجوههن َّ تحدو بهن َّ الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهنَّ أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههنَّ القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهنَّ من رجالهن ولي، ولا حماتهن حميَّ، وكيف يُرتَجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في بغضاء أهل البيت من نظر إلينا بالشَّنَفِ والشنآن والإحن والأضغان؟ ثم تقول غير متأثٍّم ولا مستعظم:
|
لأهلُّوا واستهلُّوا فرحاً |
|
ثم قالوا يا يزيد لا تشلّ |
منحنياً على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك؟ وقد نكأتَ القرحة، وأستأصلتَ الشأفة، بإراقتك دماء ذرية محمد، ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، تهتف بأشياخك، وزعمت أنَّك تناديهم فَلَتردَنَّ وشيكاً موردهم، ولتودَّنَّ أنكَ شُلِلتَ وبَكُمتَ ولم تكن قلتَ ما قلتَ، وفعلتَ ما فعلتَ· اللهمَّ خذْ لنا بحقِّنا، وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا، فوالله ما فريتَ إلا جلدك، ولا حززتَ إلا لحمك، ولتردنَّ على رسول الله’، بما تحمَّلت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في ذريته ولحمته، حين يجمع الله شملهم، ويلمّ شعثهم، ويأخذ بحقهم:(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)[294]، وحسْبُكَ بالله حاكماً وبمحمد خصيماً، وبجبرئيل ظهيراً، وسيعلم من سوَّل لك، ومكَّنك من رقاب المسلمين:(ﯖ ﯗ ﯘ)[295]، أيكم (ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)[296]، ولَئن جرَّت عليَّ الدواهي مخاطبَتَكَ، إنِّي لَأستصغر قدرك، وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك، لكنَّ العيون عبرى، والصدور حرَّى، ألا فالعجب كلَّ العجب، لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء!! فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواهُ تتحلَّب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي، تنتابها العواسل، وتعفِّرها أمهات الفراعل!! ولئن اتخذتَنا مغنماً، لتجدنا وشيكاً مغرماً، حين لا تجد إلا(ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)[297]، فإلى الله المشتكى وعليه المعوَّل· فكِدْ كيدك، واسعَ سعيك، وناصب جهدك، فواللهِ لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا يرحَضُ عنك عارها، وهل رأيك إلا فَنَد، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد؟ يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين، والحمد لله ربِّ العالمين، الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنَّه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فقال يزيد:
|
يا صيحةً تُحمَدُ من صوائح |
كان موقف السيدة زينب‘ في مجلس يزيد، من المواقف البطولية الرائعة، التي قد توازي شهادة أخيها الإمام الحسين× في تحدِّي جبروت الظلم والطغيان، فالسيدة زينب‘ وقفت أمام يزيد في موقف لا تُحسد عليه نفسياً وجسدياً، وهي الخارجة توّا من هول الفاجعة ومرارتها، وتأثيرها الهائل على إحساسها ومشاعرها، فضلاً عمّا استقبلت به من شماتة وإذلال في بلاد الشام، وما يعنيه حضورها سبيَّة وأسيرة منكسرة في ذلك المجلس، بعد سفر مرهق شاقٍّ؛ تنفيذاً لرغبة السلطة في الوصول بأسرع وقت إلى الشام برفقة جفاة صلفين كشمر بن ذي الجوشن وزجر ابن قيس، يمارسون القسوة والإضطهاد مع السبايا، وما رافق ذلك المسير من عامل الجوع والعطش الذي ابتلي به الركب في طريقهم إلى بلاد الشام، ثم إيقافهم في مكان إيقاف سبي الكفار، وإيثاقهم بالحبال كتافاً يساقون سوق الإبل حتى أُوقفوا أمام يزيد بهذه الحالة، وفي كتب المناقب كان يزيد أمامها على كرسي ملكه، في أوج القوة وزهو الإنتصار، تحفُّ به قيادات الجيش، ورجالات الحكم، وزعماء الشام مضافاً إلى حضور رسل قيصر ملك الروم، في مظهر أراد له يزيد أن يكون على أعلى درجات القوة والسطوة، ومقابل ذلك كانت السيدة زينب‘ على معرفة بفظاظة يزيد وغلظته، وقسوته في القمع، وإنَّ أيَّ إستفزاز ليزيد كان سيؤدي بالتالي إلى أسوأ الإجراءات من رجل ليس له رادع من خلق أو دين.
إلا أنَّ السيدة زينب‘ ومن وعيها لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها في إدامة زخم ثورة أخيها الإمام الحسين×، ودورها الإعلامي في فضح القيادة الأموية انطلقت بخطبتها العصماء تلك، معلنة الإدانة والإستنكار للجرائم التي اُرتُكِبت بحقِّ أهل البيت، وبأسلوب وبلاغه قلَّ نظيرهما، مظهرة سُمُوَّ مكانتها عندما كلَّمتْ يزيد وهو الحاكم والأمير، فاستهانت به واستصغرت قدره، ولم تحفل بسلطانه، مذكرةً إياه امتداد سلوكه إلى سلوكيات أسلافه من المشركين والمنافقين فذكَّرته بجدَّتِه هند بقولها «وكيف يُرتَجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء»[299]متوعِّدةً إياه بأنَّ مصيره كمصير أسلافه، وإنَّه لاحق بهم «تهتف بأشياخك، وزعمتَ أنك تناديهم فلتردنَّ وشيكاً موردهم»[300]، وفي ردٍّ واضح على يزيد في تمثـّله بقول ابن الزبعري وهو التصريح بأنَّ قتل الإمام الحسين× إنَّما هو أخذ لثارات بدر، فضحت السيدة زينب‘ تظاهر الأمويين بالإسلام بتأكيدها على وجوب الرجوع إلى القيم والمبادئ التي سنَّها الرسول’، والإحتكام إليها في تقويم الواقع وتفسير أحداثه عندما قالت ليزيد «أظننتَ يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء... »[301]، فإنَّ ذلك لم يكن دليلاً على الحقِّ والمشروعية، والصراع بين أهل البيت والأمويين في نظر السيدة زينب‘ هو مظهر من مظاهر الصراع الأبدي بين الخير والشر، بين حزب الله وحزب الشيطان، كما وصفته السيدة زينب‘، ولقد أكَّدت السيدة زينب‘ على حقيقة أرادت أن يعيها المجتمع الشامي جيداً، وهي أنَّ الحكم والولاية لآل محمد، لا لغيرهم عندما قالت ليزيد «وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا»[302]في إشارة واضحة إلى اغتصاب الأمويين لسلطان محمد من آل محمد’، وفي خطبة السيدة زينب‘ استشراف للمستقبل وتحدٍّ كبير للظلم والطغيان، فهي تتحدَّى يزيد بكل جبروته وكيده وسعيه الحثيث؛ لمحو ذكر أهل البيت^، وإماتة وحي الرسالة المحمدية، وتتنبأ بقصر أيامه، وتشتُّت جمعه، وإنَّ الإمام الحسين× وأصحابه وأهل بيته^ سيذهبون بالشرف الرفيع وعلو المنزلة والخلود مدى الدهر، وبالمقابل فإنَّ الدائرة ستدور على يزيد وعلى الدولة الأموية ولن يبقَ ليزيد سوى العار الذي سوف لا يرحض عنه بقتله للإمام الحسين×، وقد صدقت نبوءة السيدة زينب‘، فلقد كانت ثورة الإمام الحسين× اسفيناً دقَّ في جسد الدولة الأموية أدَّى بها سريعاً إلى الإنهيار والسقوط، وليعلو مقام الإمام الحسين× إلى ما وصل إليه من الرفعة والسموِّ حتى يومنا الحالي.
لقد خاطبت السيدة زينب‘، وهي تقف أمام يزيد أسيرة مكتَّفة بالحبال بكبرياء وعزة مبدية احتقارها لمن تخاطبه، وإنَّها أكبر وأسمى من أن تكلِّم الرجل الماثل أمامها لولا حكم الظروف التي حكمتها «ولئن جرَّت عليَّ الدواهي مخاطبتك، إنِّي لأستصغر قدرك، وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك»[303]، وفي مكان آخر من خطبتها قالت: «يا ابن الطلقاء»[304]. أمَّا ثقة السيدة زينب‘ بالنصر والظفر فلم يكن يقتصر على الحياة الدنيا، بل يتعداها إلى الآخرة عندما تكون العاقبة للمتقين، ولعنة الله على الظالمين، يوم يكون الله هو الحاكم، ومحمد’ هو الخصيم، وجبريل هو الظهير والمحامي، عندئذ سوف ينال الظالم ومن مكَّنه على رقاب المسلمين الجزاء العادل، في إدانة واضحة وصريحة إلى معاوية بن أبي سفيان الذي سلَّط يزيد على رقاب الناس بتوليه للعهد من بعده.
إنَّ السيدة زينب‘ كانت موفَّقة كلَّ التوفيق في خطبتها، فقد عرف من سمع الخطبة حقيقة من تكون[305]، بعدما زعمت السلطة الحاكمة أنَّ الأسارى من سبي الروم والتتر[306]، وعلى الرغم من أنَّ الشام كانت عاصمة الأمويين ومجد خلافتهم فقد سرت فيها البلبلة بعد خطبة السيدة زينب‘، وكثر الكلام بين الناس فيها، مما أضطرَّ يزيد إلى أن ينتهي من أمر السبايا سريعاً، ويتظاهر لهم بشيء من العطف ويلين إلى جانبهم؛ خوفا من انقلاب الأمر عليه؛ لذا نراه يلعن ابن زياد لتعجُّله بهذا الأمر[307]، عندما قال: «عجَّلَ عليه ابن زياد فقتله، قتله الله»[308]، أو قول يزيد أيضا «والله يا حسين لو كنت أنا صاحبك ما قتلتك»[309] أو قوله «لعن الله ابن مرجانة ··· فلم يجبهُ إلى ذلك فقتله، فبغَّضني بقتله إلى المسلمين، وزرع في قلوبهم العداوة، فأبغضني البرُّ والفاجر، بما استعظموه من قتلي الحسين، ما لي ولابن مرجانة، لعنه الله وغضب عليه»[310].
إنّ السيدة زينب‘، لم يبدُ عليها الضعف والخوف والإنكسار وهي تقف أمام رأس السلطة الأموية بجرأة وثبات، وقوة إيمان دون أن يدركها ما يدرك مثيلاتها من النساء في مثل هذه المواقف، واستطاعت أن تحطِّم نشوة النصر التي افتخر بها يزيد، وهي تلك المرأة الأسيرة المنكسرة التي فقدت للتوِّ رجالات أهل بيتها وليس معها في ذلك الموقف سوى النساء والأطفال مع رجل لا يقوى على شيء، فتحدَّثت بفصاحة وبلاغة وكأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي×.
وخلاصة القول أنّ خطبة السيدة زينب‘ حطَّمت كبرياء يزيد، وأنهت غروره، وحار في جوابه، فلم يزد بتمثُّله سوى ببيت الشعر الذي ذكرناه[311]، «وكأنه يفسِّر خطاب السيدة زينب‘ بأنه نوع من الإنفعال الطبيعي؛ لما تعانيه من مصيبة»[312]، وفي محاولة من يزيد للتمويه على الناس دعا مَنْ يخطب بالناس ويخبرهم بمساوئ الإمام الحسين× والإمام علي× وما فعلا، ففعل وأكثر من الوقيعة في الإمامين علي والحسين÷، وأطنب في مديح معاوية ويزيد، فصاح به الإمام السجاد×: ويلك أيُّها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فانظر مقعدك من النار[313]، ثم طلب منه يزيد أن يصعد إلى المنبر، فأبى، لكن الناس أجبروه على ذلك فصعد الإمام السجاد×، وخطب خطبة ضجَّ الناس منها بالبكاء[314]، وخشي يزيد أن تكون فتنة، فأمر المؤذن أن يقطع عليه كلامه بالأذان، فلما وصل المؤذِّن لقوله أشهد أنَّ محمداً رسول الله، التفت الإمام السجاد× إلى يزيد قائلاً: «محمد هذا جدي أم جدُّك؟ فإن زعمتَ أنـّه جدُّك فقد كذبت وكفرت، وإن زعمتَ أنَّه جدي فَلِم قتلتَ عترته؟ »[315].
لقد أثارت خطبة السيدة زينب‘، وخطبة الإمام السجاد× المجتمع الشامي على يزيد، وهو ما دفعه إلى إستشارة المقرَّبين له في كيفية التصرُّف مع السبي الحسيني، فقال له أحدهم: «يا أمير المؤمنين لا يتخذن من كلب سوء جرواً، أقتل علي ابن الحسين حتى لا يبقى من ذرية الحسين أحد»[316]، فقال الإمام السجاد×: إن كنت تريد قتلي فوجِّه مع النسوة من يؤديهنَّ إلى حرم رسول الله’، فقال يزيد: أمَّا قتلك فقد عفوتُ عنك، وأمَّا النساء فما يردهنَّ غيرك إلى المدينة[317].
خلاصة القول واستنادا إلى الروايات وتحليل الأحداث فإنَّ يزيدَ ومن خلال كتبه إلى واليه على الكوفة عبيد الله بن زياد كان هو الذي أعطى الأوامر بالتشديد على الإمام الحسين× وقتله إن تطلَّب الأمر، ففي كتاب له إلى ابن زياد: «بلغني أنَّ حسيناً سار إلى الكوفة، وقد ابتلي به زمانك بين الأزمان، وابتليت به من بين العمال، وعنده تُعتَقُ أو تعودُ عبداً»[318]، وفي كتاب آخر يقول فيه : «لا يغمض جفنك من المنام، ولا تشبع بطنك من الطعام، إمّا أن يرجع الحسين إلى حكمي أو تقتله والسلام»[319].
وعلى هذا الأساس لم يكن اتهام السيدة زينب أو الإمام السجاد÷ليزيد باطلاً أو ناشئاً عن فراغ؛ فلقد حرَّض يزيد واليه على المدينة بأخذ البيعة من الإمام الحسين× أو قتله، ومن ثَمَّ عمل على اغتياله في موسم الحج في مكة، ثم كانت كتبه لابن زياد يأمره بقتل الإمام الحسين×، إلا أنَّ يزيد عندما وجد أنَّ الأوضاع قد انقلبت عليه في عقر داره، وبدأت الإضطرابات في عاصمة ملكه، بل وصل الأمر إلى بيته أيضاً كما سنرى لاحقاً، كما وصلت رسائل من الأمصار الإسلامية تعنِّفه على عمله ذاك، كما في رسالة ابن عباس إليه: «يا يزيد إنَّ من أعظم الشماتة حملك بنات رسول الله وأطفاله وحرمه من العراق إلى الشام، أسارى مجلوبين مسلوبين؛ تُرِى الناسَ قدرتَك علينا، وأنَّك قد قهرتنا، واستوليت على آل الرسول في ظنِّك أنَّك أخذت بثأر أهلك الكفرة الفجرة يوم بدر، وأظهرت الإنتقام الذي كنت تخفيه والأضغان التي تكمن في قلبك...»[320]ولكل ذلك ترى يزيد يلتجئ إلى الندم على قتل الإمام الحسين× والتنكيل بالأسرى، ويعلِّق المسؤولية برقبة ابن زياد، ويبدأ بالتودُّدِ للإمام السجاد وأهل بيته^[321].
وقيل : إنَّ يزيد أمر بالنسوة ـ من آل البيت^ ـ أن ينزلنَ في دار على حدة معهنَّ ما يصلحهنَّ وأخوهن الإمام علي بن الحسين× في الدار التي هنَّ فيها[322]، بعد أن كان يزيد قد أمر بنساء الإمام الحسين× فحُبسنَ مع الإمام علي بن الحسين× في محبس لا يقيهنَّ من حرٍّ ولا برد حتى تقشَّرت وجوههنَّ[323].
ويبدو أنَّ يزيد أنزلهنَّ أول الأمر في هذه الدار الخربة، ثم نقلهنَّ إلى داره الخاصة أو إلى دار جانب داره بعدما رأى انقلاب الأمور ضدَّه «فأفرد لهنَّ داراً تتصل بدار يزيد»[324]، فخرجنَ حتى دخلنَ دار يزيد، فلم تبقَ من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهنَّ تبكي[325]، فلما دخلنَ على حرمه لم تبقَ أمرأة من آل يزيد إلا أتتْ إليهنَّ وأظهرنَ التوجُّع والحزن على ما أصابهنَّ[326].
وقيل : عندما وُضع رأس الإمام الحسين× بين يدي يزيد، وحدَّثوه الحديث فسمعت الحديث هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز ــ وكانت تحت يزيد بن معاوية ــ فتقنَّعت بثوبها وخرجت، فقالت: يا أمير المؤمنين أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله؟ قال: نعم فأعولي عليه، وحِدِّي على ابن بنت رسول الله’ وصريحة قريش، عجَّل عليه ابن زياد مقتله، فقتله الله[327].
وفي رواية أخرى أنَّ أمَّ كلثوم بنت عبد الله بن عامر بن كريزقد بكت على الإمام الحسين×، وهي يومئذ عند يزيد بن معاوية فقال يزيد: حقَّ لها أن تُعوِل على كبير قريش وسيِّدها[328]، وخرجت هند أمرأة يزيد فشقَّت الستر وهي حاسرة، وقالت: أرأس الحسين بن علي مصلوب على داري، فغطَّاها يزيد وقال: نعم، فأعولي عليه يا هند وأبكي على ابن بنت رسول الله، وصريحة قريش، عجَّل عليه ابن زياد فقتله قتله الله[329].
وهذا يدلُّ على أنَّ زوجة يزيد دخلت بعد خروج آل البيت من المجلس ودخولهم بيت يزيد، وبعد ذلك تحوَّل بيت يزيد إلى مكان لإقامة العزاء والمأتم على الإمام الحسين× وأصحابه.
«وأمر يزيد نساء آل أبي سفيان ثلاثة أيام، فما بقيت منهنَّ امرأة إلا تلقتنا تبكي وتنتحبُ ونُحْنَ على حسين ثلاثة»[330].
وقيل : إنَّ يزيد ما كان يتغدَّى ويتعشى حتى يحضر معه الإمام علي بن الحسين×[331]، وإنّ يزيد التجأ إلى هذا الاسلوب خوفاً من حصول الفتنة بخاصة أنَّ الأمر بدأينقلب عليه كما بيَّنا سلفاً.
وقيل : إنَّ يزيد أمر بردِّ ما أُخذ من نساء الإمام الحسين× أضعافاً، وأرسل يزيد إلى كلِّ امرأة ما أُخذ منها؟ وليس أمرأة تدَّعي شيئاً بالغاً ما بلغ إلا وقد ضاعفه لها[332]، وسألهنَّ عما أُخذ منهنَّ، فضاعفه لهنَّ[333].
إنَّ مطالب أهل البيت^ ما كانت لأجل الحصول على أُمور مادية، بل إنَّ هناك في ضمن ما سُلب منهم بعض مواريث أهل البيت^ الخاصة، وخاصَّة ما يتعلَّق بفاطمة الزهراء‘[334].
قيل : إنَّ الإمام علي بن الحسين× قال ليزيد: «أمّا مالُكَ فلا نريده، فهو موفَّر عليك، وإنَّما طلبتُ ما أُخذ منَّا؛لأنَّه مغزل فاطمة بنت محمد، ومقنعتها، وقلادتها وقميصها»[335].
ثم إنَّ يزيد عرض عليهم البقاء في دمشق فأبوا ذلك، وقالوا رُدَّنا إلى المدينة؛ لأنَّها مهاجرة جدِّنا[336]، ثم أمر النعمان بن بشير أن يجهِّزهم بما يصلحهم، ويسيِّر معهم رجلاً أميناً من أهل الشام، ومعه خيل تسير بهم إلى المدينة، ثم دعا بالإمام علي بن الحسين× فقال له: «لعن الله ابن مرجانة، أما والله لو أنَّي صاحب أبيك ما سألني خصلة أبداً إلا أعطيته إيّاها، ولدفعت الحتف عنه بكلِّ ما استطعت، ولكنَّ الله قضى ما رأيت، كاتِبْني من المدينة، وإنَّ كلَّ حاجة تكون لك، وتقدَّم بكسوته وكسوة أهله»[337].
وأعرض عنه الإمام؛ لأنَّ موقف يزيد لم يكن إلا تهرُّباً مما لحقه من الخزي والعار[338]، وقال يزيد للإمام علي بن الحسين×: إن أحببتَ أن تقيم عندنا فنصل رحمك، ونعرف لك حقَّك فعلت، وإن أحببت أن أردَّك إلى بلادك وأصلك، قال: بل تردَّني إلى بلادي، فردَّه إلى المدينة ووصله[339].
ولا نعرف بالتحديد الفترة التي أقامها أهل البيت^ في دمشق، إلا أنَّ ابن سعد ذكر أنّ«يزيد بعث إلى المدينة فقـدم عليه بعدِّة من ذوي السن من موالي بني هاشم، ثم من موالي بني علي، وضمَّ إليهم أيضاً عدَّةً من موالي أبي سفيان، ثم بعث بثقل الحسين ومن بقي من نسائه وأهله»[340].
وإنّ الأقوال قد اختلفت في تحديد المدَّة التي بقى فيها أهل البيت^في بلاد الشام.
وبذلك خرج الركب الحسيني من الشام، وقد أوصى يزيد الرسل بأن يعاملوهم معاملة جيدة «وأنفذ معهم في جملة النعمان بن بشير رسولاً، فقدم إليه بأن يسير بهم في الليل، ويكونوا أمامه حيث لا يفوتون طرفة، فإذا نزلوا تنحَّى عنهم وتفرَّق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم، بحيث إن أراد إنسان من جماعتهم وضوءاً وقضاء حاجة لم يحتشم، فسار معهم في جملة النعمان ولم يزل ينازلهم في الطريق ويرفق بهم كما وصَّاه يزيد يرعاهم حتى دخلوا المدينة»[341].
وقيل: إنَّ فاطمة بنت علي قالت لأختها السيدة زينب‘: لقد أحسن هذا الرجل إلينا، فهل لك أن نصله بشيء؟ فقالت: والله ما معنا ما نصله به إلا حليّنا فأخرجتا سوارين ودملجين لهما، فبعثتا بها إليه واعتذرتا، فردَّ الجميع وقال: لو كان الذي صنعت للدنيا لكان في هذا ما يرضيني، ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله’[342].
وقيل : إنَّ آل الحسين^ وهم في طريقهم إلى المدينة طلبوا من الدليل أن يمرُّوا بكربلاء«لما رجع نساء الحسين× وعياله من الشام وبلغوا إلى العراق، قالوا للدليل مُرَّ بنا على طريق كربلاء، فوصلوا إلى موضع المصرع، فوجدوا جابر بن عبد الله الأنصاري وجماعة من بني هاشم، ورجالاً من آل الرسول’ قد وردوا لزيارة قبرالإمام الحسين×، فوافوا في وقت واحد وتلاقوا بالبكاء والحزن، وأقاموا المأتم واجتمع إليهم نساء ذلك السواد، فأقاموا على ذلك أياما، ثم انفصلوا من كربلاء طالبين المدينة»[343].
وجابر بن عبد الله الأنصاري أوَّل من زار الإمام الحسين× بعد المقتل وكان ذلك في العشرين من صفر[344].
إنَّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل وصل السبايا إلى كربلاء بعد أربعين يوماً من مقتل الإمام الحسين×؟ أي :أفي العشرين من شهر صفر وصلوا، أم في وقت آخر؟ على الرغم منأنّ الذي نستشفُّه من الروايات أنَّ حرم الإمام الحسين× مكثوا في بلاد الشام شهراً أو أكثر، وكانوا قد أمضوا أياماً في الكوفة مع ملاحظة المدة التي استغرقها ذهاب الرسول من الكوفة إلى الشام، أو حساب المدة التي استغرقها ذهاب البريد من الكوفة إلى يزيد لإبلاغه بقتل الإمام الحسين×، فهل يكون المسير خلال أربعين يوماً، مع الأخذ بنظر الإعتبار نوعية الوسائل المستخدمة في التنقلات آنذاك، ومع ركب يضمُّ الأطفال والنساء؟ وقد بحث المحققون ذلك، وتبيّن أنّ وصول سبايا أهل البيت^ في العشرين من صفر إلى كربلاء، لكن يبدو لي أنَّ الأربعين يوماً كانت من تأريخ خروجهم من بلاد الشام حتى وصولهم إلى كربلاء، وهي أولى لحظات تحرُّرهم من أسر يزيد.
أرسل عبيد الله بن زياد رسولاً إلى عمرو بن سعيد بن العاص والى المدينة يحمل خبر مقتل الإمام الحسين×[345]، وقيل : إنَّ اسم هذا الرسول هو عبد الملك بن أبي الحارث السلمي[346]حيث قال: ركبت راحلتي وسرت نحو المدينة، فلقيني رجل من قريش، فقال: ما الخبر؟ فقلت الخبر عند الأمير تسمعه، قال: إنَّا لله وإنا إليه راجعون قتل والله الحسين×، ولما دخلت على عمرو بن سعيد قال: ما وراءك؟ فقلت: ما يسرُّ الأمير، قُتِل الحسين بن علي، فقال: اخرج فنادِ بقتله، فناديتُ فلم أسمع واعية قطُّ مثل واعية بني هاشم في دورهم على الحسين بن علي حين سمعوا النعي بقتله، فدخلت على عمرو بن سعيد فلما رآني تبسم اليَّ ضاحكاً، ثم أنشأ متمثلاً بقول عمرو بن معدى كرب:
|
عَجَّت نساءُ بني زياد عجَّة |
ثم قال عمرو: هذه واعية بواعية عثمان[347]،ثم صعد على المنبر، فأعلم الناس بقتل الحسين، ودعا ليزيد بن معاوية ونزل[348].
ويبدو أنَّ هذا الخبر يدلُّ على أنَّ هناك بعض الشخصيات كانت تعلم بمقتل الإمام الحسين× قبل وصول الخبر، ومما يؤكِّد ذلك بعض الروايات التي نُقِلت، منها ما روته السيدة أمُّ سلمة[349].
حيث روى «أن أول صرخة صرخت في المدينة أمُّ سلمى زوجُ النبي’، كان دفع إليها قارورة فيها تربة، وقال لها: «إنَّ جبرئيل أعلمني أنَّ أمتي تقتل الحسين، وأعطاني هذه التربة وقال لي: إذا صارت دماً عبيطا فاعلمي أنَّ الحسين قد قتل، وكانت عندها فلما حضر ذلك الوقت جعلت تنظر إلى القارورة في كلِّ ساعة، فلما رأتها قد صارت دماً صاحت وا حسيناه وابن رسول الله، وتصارخت النساء من كلِّ ناحية حتى ارتفعت المدينة بالرجَّة التي ما سُمع بمثلها قطُّ»[350].
وعن أمِّ سلمة قالت: «كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بين يدي النبي’ في بيتي، فنزل جبرئيل× وقال: يا محمد إنَّ أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك ـ فأومأ إلى الحسين ـ فبكى رسول الله’ وضمَّه إلى صدره، ثم قال رسول الله’: وديعة عندكِ هذه التربة، فشمَّها رسول الله’ وقال: ويحَ كربٍ وبلاء، قالت: وقال رسول الله’: يا أمَّ سلمة إذا صارت دماً فاعلمي أنَّ ابني قد قُتِل، فجعلتها أمُّ سلمة في قارورة، ثم جعلت تنظر إليها كلَّ يوم وتقول: إنَّ يوماً تـُحَوَّلين دماً لَيوم عظيم[351].
ولما قارب آل الرسول من الوصول إلى المدينة بعث الإمام علي بن الحسين× مَن ينعى الإمام الحسين× ويخبر بوصول السبايا إلى المدينة.
قال بشير بن حذلم: فلما قربنا منها (المدينة) نزل الإمام علي بن الحسين× فحطَّ رحله وضرب فسطاطه وأنزل نساءه، وقال: يا بشير: رحم الله أباك لقد كان شاعراً فهل تقدر على شئ منه؟ قلت: بلى يا ابن رسول الله إنِّي لَشاعر، قال: فادخل المدينة وانعَ أبا عبد الله، قال بشير : فركبت فرسي وركضت حتى دخلت المدينة، فلما بلغت مسجد النبي’ رفعت صوتي بالبكاء وأنشأتُ أقول:
|
يا أهلَ يثربَ لا مقامَ لكم بها |
قال: ثم قلت: هذا علي بن الحسين وعمَّاتُه وأخواتُهُ قد حلُّوا بساحتكم ونزلوا بفنائكم، وأنا رسوله إليكم أعرِّفكم مكانه، ثم خرجت النساء يدعون بالويل والثبور[352].
وقيل : إنّ السيدة زينب‘ أخذت بعضادتي باب المسجد، ونادت يا جدَّاه إنِّي ناعية إليك أخي الحسين[353].
وقيل: إنّ زينب بنت عقيل بن أبي طالب لما سمعت النداء بقتل الإمام الحسين× خرجت كاشفة وجهها، ناثرة شعرها، وهي تقول[354]:
|
ماذا تقولون إنْ قالَ النبيُّ لكم |
ويبدو لي أنَّ خروج السيدة زينب بنت عقيل بتلك الصفة يتنافى مع أخلاق بيت النبوة.
بعد أن أكملت السيدة زينب‘ رسالتها التي انتُدِبت لها إذ «طوت ستة عقود من سنين الدنيا في جهاد رسالي متواصل»[355]، وقد أتفق المؤرخون الذين ترجموا لحياتها أنَّها تُوفيت في الخامس عشر من رجب، واختلفوا في سنة الوفاة بين سنة 62 هـ وسنة 65هـ[356]، والأرجح لديَّ أنَّ وفاتها كانت عام 62 هـ،؛ إذ إنَّ أخبارها المتفرِّقة في كتب التأريخ انقطعت بعد هذه السنة، ولا نجد أيَّ إشارة أو أيَّ دور لها في المصادر التأريخية حتى عند من ذكر أنَّ وفاتها هو سنة 65 هـ.
وإذا كان الباحث لا يجد صعوبة في تحديد الوفاة فإنَّ مكان الوفاة ومكان قبرها‘ قد حصل فيه اختلاف كبير، وتنافست بلدان عدَّة بادعاء شرف احتضان جثمانها، وسنتناول تلك الروايات ونعرضها على بساط البحث والمناقشة للوصول إلى أقرب الروايات إلى الصحة.
وفاة السيدة زينب‘ في مصر والتحقق من مدفنها فيها
ذكر بعض المؤرخين المتأخرين أنّ السيدة زينب‘ تُوفيت ودُفنت في مصر، ويبدو أنّ أغلب هؤلاء أخذوا عن بعضهم، معتمدين على رواية يحيى بن الحسن العبيدلي المتوفى سنة (277 هـ) والمنفرد من بين المؤرِّخين المتقدِّمين بهذه الرواية، إذ قال: إنَّ السيدة زينب‘ بعد رجوعها من كربلاء مع النساء والصبيان، ثارت بينها وبين والي المدينة فتنة، مما حدا بالوالي إلى أن يكتب إلى يزيد مشيراً عليه بنفيها من المدينة، فأقرَّه يزيد على ما أراد، فقام والي المدينة بتجهيزها هي ومَن أراد السفر معها من نساء بني هاشم إلى مصر، فقَدِمتْها وأقامتْ فيها أحد عشر شهراً وخمسة عشر يوماً، واستقرَّتْ خلال تلك الفترة في دار لمِسلَمَة بن مخلَّد بالحمراء، وفيها تُوفيت ودُفنت بمخدعها بتلك الدار حسب وصيَّتِها[357]، وأكَّد العبيدلي أنَّ وفاتها كانت «لخمسة عشر يوماً مضت من رجب، سنة 62 من الهجرة»[358]، وعلى أساس هذه الرواية ـ إنْ صحّت ـ فإنَّ مرقد السيدة زينب‘ يقع في الجهة البحرية من دار مَسْلَمة بن مخلَّد الأنصاري، وقد أصبح لهذا المكان أهمية خاصة؛ لأنَّه أصبح من الأماكن المعظَّمة المقصودة لغرض الزيارة، وتناوب على خدمته أناس انقطعوا لهذا العمل، ويُصرَف على إدامة هذا المكان من الممتلكات التي أُوقِفت على هذا المرقد[359].
وفي زمن دولة أحمد بن طولون (254 ـ 293 هـ) أُجريَ على هذا المشهد ما أُجريَ على المشاهد الأخرى من عمارة وترميم، وفيما جاءت الدولة الفاطمية (358 ـ 567 هـ) كان أوَّل من بنى عمارة جليلة عظيمة على هذا المشهد الطاهر من الخلفاء الفاطميين أبو تميم معزّ ( نزار بن المعز) وذلك سنة 369 هـ.
وقد وصف هذا المشهد الرَّحَّالة أبو عبد الله محمد الفاسي الأندلسي الذي دخل القاهرة في محرم سنة 369 هـ أيام الفاطميين، والذي نقل مشاهداته عن النقوش الموجودة على المرقد المنسوب للسيدة زينب‘، ومن خلال تلك النقوش والمشاهدة يتبيَّن لنا سنة إقامة العمارة الأولى لهذا المشهد؛ إذ نُقل عن الرحَّالة المذكور أعلاه أنَّه شاهد كتابة على باب حجرة المرقد تقول: «هذا ما أمر به عبد الله ووليه أبو تميم أمير المؤمنين... أمر بعمارة هذا المشهد على مقام السيدة الطاهرة بنت البتول، زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب»[360].
وفي القرن السادس الهجري أيام الملك سيف الدين أبي بكر بن أيوب أجرى الشريف فخر الدين ثعلب الجعفري، أمير القاهرة ونقيب الأشراف الزينبيين بها عمارة وإصلاحاً على هذا المشهد، واهتمَّ الأمير علي باشا الوزير والي مصر من قبل السلطان سليمان خان بن السلطان سليم الفاتح بتعمير المشهد وتشييده، وجعل له مسجداً يتصل به، وذلك سنة 956 هـ، وفي سنة 1174 هـ أعاد الأمير عبد الرحمن كتخدا القازدوغلي بناءه وتشييده، وبنى مقام الشيخ محمد العتريس المتوفى في آواخر القرن السابع الذي كان ملازماً لخدمة المشهد الزينبي، وفي سنة (1210هـ) جُدِّدت المقصورة التي تحيط بالتابوت الطاهر المقام فوق القبر وصُنعت من النحاس الاصفر، وكُتب علها «يا سيدة زينب يا بنت فاطمة الزهراء مددك 1210 هـ»، وما زالت على الضريح الشريف حتى اليوم، وحدث في سنة 1212 هـ أن تصدَّعت جدران المسجد، فانتدبت حكومة المماليك عثمان بك المرادي لتجديده وإعادة بنائه إلاأنَّ العمل توقَّف بسبب الحملة الفرنسية على مصر إلى أن أكمله بعد ذلك يوسف باشا الوزير سنة 1216 هـ[361].
وبعد ذلك أصبح المشهد الزينبي في مصر تحت رعاية حكّام مصر من أسرة محمد علي، ففي سنة (1270 هـ) شرع الخديوي عباس باشا الأوّل في إصلاحه ووضع حجر الأساس ولكنَّ الموت عاجله، فقام الخديوي محمد سعيد باشا في سنة 1276 هـ بإتمامه، وفي سنة 1291 و1294 هـ أُجرِيت تعديلات على المقام الشريف[362].
أمَّا المسجد القائم حالياً فقد تمَّ إنشاؤه على مراحل ثلاث، ففي الجزء الأوَّل منه وهو المطلُّ على الميدان المعروف باسم ميدان السيدة زينب في عهد الخديوي توفيق سنة (1302 هـ)، وظلَّ المسجد على تلك الحال حتى تمَّت توسعته من الجهة القبلية بمساحة (1500 م2) في عهد الملك فاروق الأوَّل وافتُتِح للصلاة في يوم الجمعة (19 ـ ذيالحجة ـ 1360)، ولما رأت حكومة جمال عبد الناصر زيادة إقبال الناس على هذا المسجد أمرت بإجراء توسعة عظيمة بلغت حوالي (2500م2) من الجهة القبلية، كما أُقيمت به دورة مياه كبيرة للطهارة والوضوء، ومكتبة ضخمة تضمُّ عشرات الألاف من المجلدات، وأُلحقت بها قاعة فسيحة للمطالعة، واكتملت هذه التوسعة سنة (1389 هـ) فأصبحت مساحة المشهد الزينبي وملحقاته تزيد على (7000م2)، أمَّا المئذنة التي تُعدُّ فريدة من نوعها، لما تتحلَّى به من نقوش وزخارف عربية جميلة فإنَّ ارتفاعها يقرب من (45م)[363].
وقيل: إنّ أهل مصر، بعد مرور عام على وفاة السيدة زينب‘ اجتمعوا قاطبة وفيهم الفقهاء والقرّاء وغيرهم وأقاموا لها موسما ً عظيماً باسم ذكرى وفاتها على ما جرت به العادة من إقامة مجلس العزاء بعد مرور عام على وفاة الميت، ومن ذلك الحين لم ينقطع إحياء هذه الذكرى، ويُعبَّر عن موسم إحياء هذه الذكرى في مصر (بالمولد الزينبي) الذي يبدأ من أوَّل شهر رجب من كلِّ سنة، وينتهي ليلة النصف منه، وتُحيى هذه الليالي بتلاوة آيات القرآن الكريم، وقراءة مدائح أهل البيت النبوي، ويَفِد الناس من كلِّ فَجٍّ عميق إلى زيارة ضريحها الشريف[364].
لم يذكر كثيرٌ من المؤرخين الذين كتبوا في تأريخ مصر، وفي أخبار ملوكها وحوادثها أنَّ هنالك قبراً للسيدة زينب‘ في مصر، ومنهم المقريزي حيث ذكر الشيعة في مصر ورسومهم في عهد الفاطميين واجتماعهم في يوم عاشوراء عند مشهد أمِّ كلثوم، والسيدة نفيسة[365].
وقد تفحَّصْـنا كتابه فلم نجد أيَّ ذكر لقبر السيدة زينب‘ في مصر، مع أنَّ المقريزي ذكر مقتل الإمام الحسين×، وأخبار السيدة زينب‘ في كربلاء عند ذكره لرأس الإمام الحسين× المدفون في مصر[366].
ومن الأمور التي تنفي وجود قبر للسيدة زينب‘ في مصر أنّ ابن تغري بردى (ت 874هـ) الذي كتب في تأريخ مصر، وأخبار ملوكها وأمرائها وخلفائها، وبعد أن تتبَّعنا الروايات المحصورة بين عامي (62 ـ 65هـ) التيتدلُّعلىوفاتها‘ لم يذكر دخولها إلى مصر، مع العلم أنَّه ذكر دخول السيدة نفيسة إلى مصر ووفاتها بها[367].
وقد أفرد بعض المؤرِّخين المحدَثين كتباً ورسائل؛ للتحقيق في هذا الموضوع ومن بينهم البحّاثة الباكستاني محمد حسنين السابقي الذي وضع كتاباً يقع في أكثر من (240 صفحة) ونحن نقتبس منه هذه الفقرات:
إنَّ رحلة السيدة زينب‘ إلى مصر وإقامتها هناك، وحديث مدفنها حادث لا يخفى على كلِّ مؤرِّخ فَطِن، وعدم الإشارة إليه أمر يثير التساؤل، خاصَّة المؤرِّخين الذين نشأوا في مصر، ولكنَّهم بأجمعهم لم يشيروا إليه أدنى إشارة.
فأوَّل مدوّن لتاريخ مصر هو كتاب عبد الرحمن بن عبد الحكم المصري(ت 257 هـ) (منهج السالك في أخبار مصر والقرى والممالك)، وتبعه أبو عمرو محمد ابن يوسف الكندي (ت 354 هـ)، وله مؤلَّفات في تاريخ مصر، وكذلك أبو محمد حسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المصري (ت 387 هـ)، وأبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي الشافعي (ت 453 هـ) وكتابه (أنس الزائرين) تَرجم فيه للسيدة نفيسة وعيَّن مدفنها، وليس فيه ذكر لقبر السيدة زينب الكبرى‘، يضاف إلى ذلك جماعة من مؤرِّخي مصر ممن ذكر المزارات والقبور والمساجد كابن يونس والهتاني، والقرشي صاحب (المزارات المصرية)، وابن سعد النسّابة صاحب (مزارات الأشراف)، وابن عطايا، والحموي الذي ذكر جملة من مزارات مصر وموفَّق الدين صاحب (مرشد الزوار)، نرى هؤلاء الأعلام يترجمون لأصحاب القبور، ويميِّزون المزارات الصحيحة من العلويين وغيرهم في مصر، ولم يذكر أحد من هؤلاء أنَّ العقيلة زينب الكبرى‘ مدفونة في مصر[368].
كما أنّ كبار المؤرِّخين المطّلعين على تاريخ مصر بدقة وتحقيق لم يصحّ لديهم دخول أيِّ ولد لأمير المؤمنين علي× لصلبه مصر، قال الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي (ت 576 هـ): لم يمت له (أي لعلي×) ولد لصلبه في مصر، وقال الحافظ المؤرِّخ أبو محمد حسن بن إبراهيم بن زولاق الليثي المعمري (ت 387 هـ)أوَّل من دخل مصر من ولد علي سكينة بنت علي بن الحسين، وفي ذلك يقول السخاوي: إنَّ المنقول عن السلف أنَّه لم يمت أحد من أولاد علي لصلبه في مصر، فكيف من المعقول أن تدخل العقيلة زينب‘ وتقيم هناك زهاء السنة، ثم تُقبر على مرأى من المحاشد الجمَّة ومسمع ولا يعرف أمرها أحدٌ من المؤرِّخين الذين عهدهم قريب بتلك الحادثة، حتى أنَّ الإمام الشافعي مع ولائه لأهل البيت^ لا يعرفها في مصر ولا يزور قبرها، وقد ورد في سيرته أنَّه كان يزور السيدة نفيسة فكيف يسعنا الإثبات أنَّ العقيلة زينب‘ مدفونة بمصر، ومحمد بن الربيع الجيزي الذي كان أبوه من أصحاب الشافعي أفرد جزءًا في ذكر الصحابة، وترجم لأكثر من مائة منهم وليس فيهم ذكر للسيدة زينب‘، ودخولها مصر، وموتها فيها[369].
كذلك دخل مصر الرَّحَّالة المسلمون الذين تجوّلوا في أنحاء واسعة من مختلف البلدان الإسلامية في القرون الوسطى ضبطوا ما شاهدوا من الآثار من جوامع ومقابر ومدارس وغيرها، ولا أحدَ منهم ذكر قبر السيدة زينب‘ في مصر .
ابن جبير الأندلسي (ت 614 هـ): دخل مصر، وذكر في رحلته مشاهد أهل البيت^، وعدَّها أربعة عشر مشهداً للرجال وخمسة للنساء، وقال: على كلِّ واحد منها بناء حافل، وروضات بديعات الإتقان، عجيبات البنيان، وذكر العلويات ومشاهدهنَّ: «مشهد السيدة أم كلثوم ابنة القاسم بن محمد بن جعفر رضي الله عنهم، ومشهد السيدة زينب ابنة يحيى بن زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم، ومشهد أمِّ كلثوم ابنة محمد بن جعفر الصادق رضي الله عنهم، ومشهد السيدة أمِّ عبد الله بن القاسم بن محمد رضي الله عنهم»[370]، ثم يضيف «وأُخبِرنا أنّ في جملتها مشهداً مباركاً لمريم ابنة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مشهور، لكنَّا لم نعاينه»[371]، وقد تلقى ابن جبير أسماء صاحبات هذه المشاهد من التواريخ الثابتة عليها، و«مع تواتر الأخبار بصحَّة ذلك»[372]، ولو كان هناك قبر للسيدة زينب‘ لزاره أو سمع عنه كما سمع عن قبر مريم الذي لم يزره.
ابن بطوطة (ت 777 هـ): ذكر المزارات في مصر؛ منها مشهد رأس الإمام الحسين بن علي×، ومشهد السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد بن علي بن الحسين×، وتربة الشافعي، ثم قال: «بقرافة مصر من قبور العلماء والصالحين ما لا يضبطه الحصر، وبها عدد جمٌّ من الصحابة وصدور السلف والخلف»[373]، ولا نرى في مشاهداته بعد تفحُّصنا كتابه أيَّ أثر لقبر السيدة زينب‘ في مصر.
الحموي البغدادي: دخل مصر وذكر عدداً من مزارات للعلويات؛ منها مشهد آمنة، ومشهد رقية، ومشهد السيدة نفيسة، ومشهد فاطمة بنت محمد بن إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق×، ومشهد أمِّ عبد الله، ومشهد أمِّ كلثوم بنت القاسم[374]، ولا نجد أيَّ ذكر لقبر العقيلة زينب‘ في مصر.
وقد اختلفت آراء المحدَثين حول مكان دفنها في مصر، فمنهم من قال إنَّ المدفونة بمصر هي زينب بنت يحيى المتوَّج بن الحسن الأنور بن زيد بن الحسن بن علي بن ابي طالب[375].
ومنهم مَن قال : ما المانع من أن تكون السيدة زينب بنت علي^ هي المدفونة بمصر حتى لو كان والي مصر الذي استقبلها والياً من قبل بني أمية؟ ولربَّما كان اللازم أن يستقبل السيدة زينب‘؛ تنفيذاً منه للمخطَّط الأموي الذي أمر بإبعاد السيدة زينب‘؛ لذلك أسكنها في قصره، لكي تكون تحرُّكاتها تحت مراقبته وإشرافه المباشر[376].
إنَّ الإشتباه بوجود قبر العقيلة زينب‘ في مصر نشأ لتعدُّد المسمَّيات بزينب من العلويات وغيرهن من المدفونات بمصر، والذهن أسرع تبادراً عند سماع الاسم إلى أشهر الأفراد وأكملها[377].
ومن الأمور المهمة الأخرى أنَّ ابن طباطبا يحيى بن محمد الحسيني العلوي المتوفي (478هـ) الذي صنَّف كتابا خاصَّاً لمن دُفن من أبناء الإمام علي بن أبي طالب× في مصر والشام، وثَّق مراقد ومزارات أبناء الإمام× في تلك النواحي من دون ذكر مرقد للسيدة زينب‘[378].
إنَّ مناقشةً دقيقة لما تقدَّم من الروايات توصلنا إلى استبعاد رواية مدفنها في مصر اذ أنَّ السيدة زينب‘ هي زوجة عبد الله بن جعفر، وهو من الشخصيات البارزة على صعيد الدولة، وعمَّة الإمام السجاد×، تخرج مع ابنة أخيها إلى مصر ولم يخرج معها أحد من رجال بني هاشم، ولم يذكر لنا أيُّ مصدر تأريخي أنَّ عبد الله ابن جعفر قد ذهب إلى مصر خلال تلك الفترة، فهل يمكننا أن نتصوَّر أنَّ الرجل قد ترك وأهمل زوجته بعد معاناتها في مأساة الطف، ومقتل أولادها وإخوتها وأهل بيتها، ومن ثَمَّ يتركها لتموت وحيدة من دون أن يزور قبرها، ثم إنّ يزيد بعد انقلاب الوضع عليه في بلاد الشام، وإرجاعه الأسرى إلى المدينة، ومحاولته التنصُّل من مسؤولية مقتل الإمام الحسين×، أرجع الأسرى بإكرام إلى المدينة وحاول استرضاءهم، وسنرى عند مناقشة رواية مدفن السيدة زينب‘ في المدينة المنورة، أنَّ يزيد قد استثنى الإمام السجاد× وأهل بيته من العقوبة التي فرضها على أهل المدينة بعد وقعة الحرة، وهو ما يناقض رواية نفي السيدة زينب‘ إلى مصر.
ويبدو لي أنَّ الفاطميين(*) ـ إبّان فترة صراعهم مع الدولة العباسية ـ حاولوا استقطاب هوى الناس وبخاصة أنّ السِّمَة الغالبة على تلك الدولة هو ولاؤها لأهل البيت^، ولما كانت كلُّ مراقد الأئمة من آل البيت وأبنائهم^ ضمن حدود الدولة العباسية فقد قام الفاطميون بأعمال حاولوا من خلالها إظهار مصر مركزاً لآل الرسول؛ من قبيل أنَّ رأس الإمام الحسين× كان مدفوناً في عسقلان وتمَّ نقله إلى مصر وبناء مسجد عليه، يزار إلى يومنا هذا، وروَّجوا رواية نفي السيدة زينب‘ إلى مصر ووفاتها فيها، وأقاموا ذلك المرقد المنسوب إليها، ومن تلك الروايات التي (رُقِّمت أيام الفاطميين)[379]على المرقد أخذ المؤرخون يؤكِّدون أنّ السيدة زينب‘ دُفِنت في مصر، ونعتقد أنَّ هذا القبر قد يعود إلى إحدى العلويات التي ينحدر نسبها إلى آل البيت^، إلا أنَّ الشبهة قد حصلت من قِبَل كثرة اللواتي يُسمَّين بزينب، بخاصة أنَّ أتباع أهل البيت^ يتبرَّكون بهذا الاسم، لذلك ترى أنَّ أغلب القبور التي تُذكَر لعلويات دُفِنَّ فيها يُنسبْنَ إلى رسول الله’ وأمير المؤمنين علي× بلا واسطة.
وفاة السيدة زينب‘ في بلاد الشام والتحقُّق من ذلك المدفن
الرواية الثانية لوفاة السيدة زينب‘ تشير إلى أنَّ السيدة زينب‘ بعد رجوعها إلى المدينة من واقعة الطف استقرَّت في المدينة المنورة حتى عام (65هـ)، وأنَّها انتقلت من المدينة مع زوجها عبد الله بن جعفر إلى ضيعة في بلاد الشام في قرية قرب دمشق يُقال لها (راوية)(*)، وذلك بسبب مجاعة حصلت في المدينة المنورة في تلك السنة، وتُوفِّيت السيدة زينب‘ في تلك القرية، ودُفِنت فيها، ثم شُيِّد المرقد المعروف باسمها اليوم على قبرها[380]، وبناءً على هذه الرواية فإنَّ قبر السيدة زينب‘ يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من دمشق على بعد سبعة كيلومترات منها، وهي المنطقة التي تُعرَف اليوم باسم السيدة زينب في سوريا[381].
وقد زار المشهد الرحَّالة ابن جبير، وقال عنه : «ومن مشاهد أهل البيت رضي الله عنهم مشهد أمِّ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويقال لها زينب الصغرى، وأمُّ كلثوم كنية أوقعها عليها النبي صلى الله عليه وسلم لشبهها بابنته أمِّ كلثوم ومشهدها الكريم بقرية قبلي البلد، يُعرَف براوية، على مقدار فرسخ، وعليه مسجد كبير، وخارجه مساكن، وله أوقاف، وأهل هذه الجهات يعرفونه بقبر السِّتِّ أمِّ كلثوم، مشينا إليه وبتنا به، وتبركنا برؤيته»[382].
كما زار هذا المشهد الرحَّالة ابن بطوطة وقال عنه عند ذكر مزارات دمشق: بقرية قبلي البلد وعلى فرسخ منها مشهد أمِّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة^ ويُقال إنَّ اسمها زينب، وكنَّاها النبي’ أمَّ كلثوم؛ لشبهها بخالتها أمِّ كلثوم بنت رسول الله’، وعليه مسجد كبير، وحوله مساكن، وله أوقاف، ويسمِّيه أهل دمشق قبر السِّتِّ أمِّ كلثوم[383].
وقال ابن عساكر «ومسجد راوية مسجد على قبر أُمِّ كلثوم، وأمُّ كلثوم هذه ليست بنت رسول الله’ التي كانت عند عثمان؛ لأنَّ تلك ماتت في حياة رسول الله’ ودُفِنت في المدينة، ولا هي أمُّ كلثوم بنت علي من فاطمة التي تزوجها عمر؛ لأنَّها ماتت هي وابنها زيد بن عمر بالمدينة في يوم واحد ودُفِنا بالبقيع، وإنَّما هي امرأة من أهل البيت سُمِّيت بهذا الاسم ولا يحفظ نسبها، ومسجدها هذا بناه رجل قرقوبي من أهل حلب»[384].
وقال الحموي البغدادي «راوية قرية من غوطة دمشق بها قبر أمِّ كلثوم، وقبر مدرك بن زياد الفزاري الصحابي»[385].
وقيل : يوجد في قرية (راوية) على نحو فرسخ من دمشق إلى جهة الشرق قبر ومشهد يُسمَّى «قبر السِّتِّ، ووجد على هذا القبر صخرة مكتوب عليها: هذا قبر السيدة زينب الصغرى المكنَّاة بأمِّ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب، أمُّها فاطمة البتول سيدة نساء العالمين ابنة سيد المرسلين محمد’[386]، إلا أنَّ الرواية ترجِّح أنَّ القبر لزينب الصغرى أخت السيدة زينب الكبرى‘[387].
وورد أنَّ السيدة نفيسة صاحبة المقام المعروف في القاهرة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن علي بن أبي طالب قد زارت هذا المشهد في قرية راوية سنة 193هـ[388].
وتوالت على مقام السيدة زينب‘ حملة من المجهودات لإعمار الصحن الشريف.
ففي عام (768 هـ) أَوقف على هذا المشهد ـ بوصفه مرقداً للسيدة زينب‘ ـ نقيبُ الأشراف السيد حسين الموسوي من كبار أعلام دمشق ما كان يملكه من البساتين والأراضي، وكتب صكّا طويلاً عليه شهادات سبعة من قضاة دمشق الكبار في زمانهم، ونسخة هذا الصَّكِّ محفوظة عند سدنة المقام، وفي سنة (1302 هـ) جدَّد القبةَ الكريمة السلطان عبد العزيز خان العثماني بإعانة التجار والأثرياء، وفي سنة (1354 هـ) أنشأ سادة آل النظّام غرفاً كثيرة حول المقام لإراحة الزائرين وجدَّدوا المدخل الشريف بنفقتهم[389].
وفي سنة (1370 هـ) شكَّل السيد محسن الأمين العاملي لجنة من خيار التجار وأهل الثروة لتعمير الحرم والصحن والأروقة، وكان من أبرز المتبرِّعين مهدي بهبهاني، وفي السنة نفسها أهدى التاجر الباكستاني محمد علي حبيب قفصاً ثميناً لِيُنصبَ على قبرها، وفي سنة (1373 هـ و1380 هـ) أهدى بعض التجار الإيرانيين صندوقاً وباباً من الذهب، وفي عام (1413 هـ) تمَّ إكساء قُبَّة المقام من الخارج بالذهب[390].
ويبدو لي من مناقشة الروايات التي أَوردت خبر دفن السيدة زينب‘ في بلاد الشام أنَّها روايات لمؤرِّخين متأخرين، وبعض مشاهدات لبعض الرحَّالة، لكنني لم أجد في كتب المتقدِّمين ما يؤيِّد ما جاء في تلك الروايات، بل إنَّني من خلال تصفُّح كتب التأريخ لم أجد أيَّ إشارة إلى حصول مجاعة في المدينة المنورة خلال السنوات المحصورة بين 62ـ65هـ،، اللهمَّ إلاّ إذا كانت المجاعة قد حصلت أيام حصار المدينة إبَّان واقعة الحرة، وعلى فرض صحَّة حصول المجاعة، فإنَّ عبد الله بن جعفر كان بإمكانه بيع غلَّاته من ضيعته والإتيان بثمنها إلى المدينة؛ ليعتاش هو وزوجته منه وهو ما يخالف طبيعة عبد الله الذي كان يُعَدُّ من أجواد العرب، وإنَّ المجاعة لو كانت حصلت بالفعل لأتى بغلّاته إلى المدينة لإعانة أهلها، لا أن ينأى بنفسه وزوجته عما أصاب أهل المدينة؛ لينعم بالخيرات من دونهم، وهو ما يخالف طبيعته ونفسيته المشهورة بالكرم والجود، ثم كيف يعقل أنَّ السيدة زينب‘ وهي الخارجة من الشام بذلك المنظر الأليم من الأسر والذلِّ أن تترك المدينة موطن جدِّها وآبائها؛ لتسكن في بلد لا يُذكَر أحد من أهلها فيه إلّا بسوء، وحتى الإشارات التي وردت في مشاهدات الرحَّالة فإنَّها لم تذكر صراحة أنَّ القبر الموجود في قرية راوية هو للسيدة زينب‘، فابن جبير قال: بأنَّه قبر أمِّ كلثوم، وسماها زينب الصغرى[391]، في حين أنَّ السيدة زينب‘ معروفة تأريخياً بزينب الكبرى، وابن بطوطة قال عن القبر: هو لأمِّ كلثوم بنت علي[392]، في حين نفى ابن عساكر وهو الذي أرَّخ لدمشق، وهو أعرف بأصولها أن يكون القبر الموجود في قرية راوية للسيدة زينب‘ إنَّما هو لامرأة من أهل البيت سُمِّيت بهذا الاسم كما يقول[393].
ويبدو لي، بناءً على ما تقدَّم، أنّ هذه الرواية لم تُذكر إلا للتقليل من شأن هذه السيدة العظيمة‘، التي تترك أهلها في محنتهم (المجاعة) ـ إن صحَّت ـ لتنعم هي وزوجها في ضيعتهم الفارهة في بلاد الشام بالخيرات، وهو تصرُّف بعيد عن أخلاق أهل بيت النبوة^، ومما يسند رأيي هذا أنَّ ابن طباطبا في كتابه لم يوثِّق وجود قبر للسيدة زينب‘ في بلاد الشام[394].
وفاة السيدة زينب‘ ومدفنها في سنجار
في رواية ثالثة ذكر بعض المؤرِّخين أنَّ مرقد السيدة
زينب‘ موجود
في سنجار(*)، واشتهرت هذه
المدينة بكثرة المراقد والأضرحة الموجودة
فيها والمنسوبة لآل البيت، التي عمَّرها البويهيون(**)
والحمدانيون(***) والعقيليون(****)، وزعم الذين قالوا بهذه
الرواية أنَّ السيدة زينب‘، توفيت في هذه المنطقة عند مرور السبايا بها بعد واقعة
الطف في طريقهم إلى الشام، والكلمات المنقوشة على البناء ترجع تأريخ بنائه إلى سنة
(644هـ)[395].
ويبدو أنَّ السبب الذي دفع الفاطميين إلى إظهار قبر للسيدة زينب‘ في مصر[396]، هو نفسه الذي دفع غيرهم من الدويلات التي مرَّ ذكرها أعلاه في إظهار قبر لها في سنجار، كما أنَّ ما ينسف هذه الرواية بالكامل هو إجماع كلِّ الروايات التأريخية على وصول السيدة زينب‘ إلى الشام وخطبتها بمجلس يزيد، ولم يذكر أي مصدر تأريخي أنَّها تُوفيت في سنجار عند مرور السبايا على تلكالمنطقة، وعلى فرض أنَّ ناقل الرواية قصد بها في طريق العودة فإنَّ المتتبع سوف لا يجد أيَّ نصٍّ يزعم أنّ السيدة زينب‘ لم ترجع إلى المدينة بعد واقعة الطف، إذ أجمع المؤرِّخون المتقدِّمون منهم والمتأخرون أنَّ السيدة زينب‘ قد رجعت إلى المدينة المنورة، وعلى فرض أنَّ ذلك قد حصل، لَذكرَه المعَزُّون لزوجها وواسَوه على فقدها، إلا أنَّ المؤرِّخين ذكروا خبر مواساتهم لعبد الله بفقده لأولاده فقط[397]، وهو ما يدفعنا إلى استبعاد هذه الرواية نهائياً.
وفاة السيدة زينب‘ ومدفنها في المدينة المنورة
الرأي الأخير من الآراء التأريخية في قضية مرقد السيدة زينب‘، هو الرأي القائل بدفنها في المدينة المنورة، وقد ثبت تأريخيا من خلال ما تمَّ إيراده من النصوص التأريخية التي قدمناها في الصفحات السابقة أنَّ السيدة زينب‘، قد رجعت مع السبايا من آل بيتها بعد واقعة الطف إلى المدينة المنورة، ولكنَّ الذي لم يثبت تأريخياً هو هل أنَّ السيدة زينب‘ قد استقرَّت في المدينة أم خرجت منها إلى مكان آخر فيما بعد حيث توفيت ودفنت؟
إنَّ المتتبع للروايات التأريخية سوف لن يجد دليلاً ماديّاً على دفنها‘ في المدينة المنورة، بخاصة أنَّ قبور البقيع معروفة، ذكرها المؤرِّخون المتقدِّمون مثل ابن شبه في كتابه تأريخ المدينة المنورة، وابن النجار في كتابه تأريخ المدينة، والسمهودي في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، إذ لا نجد في هذه الكتب خبراً للسيدة زينب‘، لا في القبور المعمورة ولا في التي طُمِست[398]، ولم يذكر ذلك أحد من المتأخرين كما حصل بالنسبة للأماكن الأخرى التي عُيِّن لها قبر فيها؛ كمصر وبلاد الشام وسنجار، كما أنَّنا لم نجد في الكتب التي كتبها أئمة أهل البيت^ أو أصحابهم ذكراً لمزار، أو قبر للسيدة زينب‘ من قِبَلِهم.
وعلى الرغم من هذه الأدلة التي تبدو من وجهة نظر بعض المؤرِّخين كافية لنفي دفن السيدة زينب‘ في المدينة المنورة، ولكن يبدو لي أنَّ وجود مرقد السيدة زينب‘ في المدينة المنورة هو أرجح الآراء؛ إذ «لم يثبت أنَّها بعد رجوعها للمدينة خرجت منها، وإن كان تأريخ وفاتها ومحلُّ قبرها بالمدينة مجهولين، ويجب أن يكون قبرها بالبقيع، وكم من أهل البيت أمثالها مَن جُهِل محلُّ قبره، وتأريخ وفاته، خصوصاً النساء»[399].
وعلى الرغم من أنّ المتتبع لتأريخها‘، يجد انقطاع أخبارها عن صفحات التأريخ بعد عودتها من كربلاء، فإن ذلك يدلِّل على أنَّها بقيت حية لفترة قليلة بعد الواقعة، وهو ما يرجِّح كون وفاتها هو سنة 62 هـ،، ولعلَّ ذلك يرجع لتسلُّط الحكم الأموي ومحاولاته في تغييب أخبار العلويين عامة، وأهل البيت^ بصورة خاصة، بعد واقعة الطف، والضغط الإعلامي الذي استخدمته الدولة في سبيل التكتُّم على أخبار أهل البيت^ كان السبب في عدم وجود روايات واضحة عن مصير كثير منهم، كما أنَّ تسارع الأحداث التأريخية، وتوالي الثورات على السلطة الأموية التي أدَّت بالتالي إلى انهيار الفرع السفياني من الدولة، وانتقاله إلى المروانيين وابتداء تلك الثورات من المدينة المنورة بالتحديد عبر واقعة الحرة، (*) وشدَّة القمع الذي استخدمته السلطة مع الثائرين، وكثرة من قُتل أو تُوفي، ففي تلك الفترة شُغِل المؤرِّخون بالكتابة عن تلك الأحداث دون النظر إلى كلِّ من تُوفي في المدينة لكثرتهم كما نوَّهنا، ولعلَّ أبرز دليل على ذلك أنّ المؤرِّخين ممن كتبوا على طريقة الحوليات؛ كالطبري وابن الأثير وغيرهما يختتمون السنة بأبرز الأحداث التي حصلت فيها، ثم يعقِّبون بذكر أبرز مَن تُوفي في تلك السنة، ولكننا لم نجدهم يذكرون أحداً في تلك السنوات، ولئن كان قبر السيدة زينب‘ مجهولاً في المدينة المنورة فمن المحتمل أنَّه نُسِي بسبب تسارع وطأة الأحداث وقسوتها، وكثرة من مات أو قتل في المدينة في تلك الفترة، أو أنَّ السيدة زينب‘ رغبت في أن يُخفى قبرها بعد أن أوصت بأن تدفن بالبقيع إلى جنب أمها‘ «ويُخفى موضع قبرها تأسِّياً بأمِّها الزهراء‘»[400]، أو خوفاً من اكتشاف موضع قبرأُمِّها الزهراء‘ بعد دفنها إلى جانبها، وأينما يكن موضع دفنها‘ فإنَّ الله عزوجل أراد لهذه السيدة العظيمة أن يكون لها أكثر من مكان تُزار فيه؛ وذلك كرامة لما قدَّمته من التضحيات ولمكانتها السامية.
بعد أن أكملت ـ بتوفيق الله سبحانه وتعالى ـ بحثي الذي تناول السيدة زينب‘ ودورها في أحداث عصرها الذي توخيت فيه الدقَّة العلمية، والرصانة للوصول إلى الحقيقة التاريخية المجردة، فإنِّي سأحاول في هذه الخاتمة تسليط الضوء على بعض الحقائق، مضافا إلى ما سيجده القارئ في ثنايا البحث من آراء واستنتاجات وتحليلات علمية.
اختلف الرواة في سنة ولادتها‘، ولكنِّي وجدت أنّ السنة الخامسة للهجرة هي أقرب السنين لولادتها، ويؤيِّد كلامنا هذا أنَّ السيدة زينب‘ قد روت خطبة أُمِّها الزهراء‘ بعد وفاة الرسول’ مباشرة.
لُقِّبت السيدة زينب‘ بألقاب عديدة، كان لها مساس بدورها البطولي بعد مأساة كربلاء، وهي ألقاب وكنى اختصَّت بها وحدها، إلا أنّ كنيتها أُمّ كلثوم أوقعت كثيراً من المؤرِّخين في لبس، وخلط بعضهم بينها وبين أخت لها تُسمَّى بأُمِّ كلثوم.
لم تذكر لنا المصادر التأريخية القديمة أية أخبار عن نشأتها الأولى، مما ضيَّع علينا مرحلة مهمَّة من تأريخ هذه السيدة العظيمة، ولكن ذلك لم يُثنِنا في محاولات البحث والتقصي عن تلك الفترة؛ إذ حاولنا قراءة مابين السطور؛ للوصول إلى بعض الأخبار التي تسلِّط الضوء على هذه المرحلة من حياتها‘.
وأمَّا فضائل السيدة زينب‘ ومناقبها وعلمها فهي أكبر من أن تُعدَّ.
لم يقم الإمام الحسين× في مكة أو المدينة؛ احتراماً للحرمين، وذلك لعلمه أنَّ يزيد لن يتورع عن انتهاك حرمة الحرمين فيما لو تطلَّب الأمر قتل الإمام الحسين×، أو أسره في داخل الحرمين الشريفين.
وجود روايات تؤكِّد أنَّ الإمام الحسين‘ كان عالما بمصيره وحاله؛ نتيجة للأخبار المتواترة عن الرسول’ بشأنه؛ لذلك أخذ نساءه وأطفاله معه؛ لكي لا يُطمس أثر الثورة، ولكي يشكِّل ذلك إدانة للسلطة الأموية التي سارت ببنات الرسول’ وأبنائه أسارى وسبايا.
إنَّ الإمام الحسين× لم يبدأ بالقتال، وإنَّما وعظهم وأرشدهم وحذَّرهم من مغبة العمل الذي يقدمون عليه؛ لكي لا يكون لهم عذر فيما بعد.
إنَّ الدور الفعلي للسيدة زينب‘ بدأ بعد فاجعة كربلاء؛ إذ كان عليها أن تحافظ على نسل آل محمد’ المتمثِّل بالإمام السجاد×، والمحافظة على عيال الرسالة وبناتها بعد الواقعة، فضلاً عن دورها الإعلامي في فضح مفاسد الحكم الأموي؛ لاستكمال الرسالة التي ثار من أجلها الإمام الحسين×.
امتازت السيدة زينب‘ في كلِّ المواقف التي تلت اليوم العاشر من المحرَّم برباطة الجأش، والشجاعة وفصاحة اللسان، بحيث أخرست ألسنة ممثِّلي السلطان الأموي في كل مكان حلُّوا فيه، سواء أكان ذلك في مسجد الكوفة أم في دار أمارتها أم في مجلس يزيد فيما بعد.
أثارت خطبة السيدة زينب وخطبة الإمام السجاد÷ سخط المجتمع الشامي على رموز الحكم الأموي؛ مما دفع يزيد إلى محاولات التنصُّل من قتل الإمام الحسين×، ملقياً باللائمة في قتله على عاتق عبيد الله بن زياد، بل دفعه ذلك إلى التودُّد إلى سبايا أهل البيت وإعادتهم سريعاً إلى مدينة جدِّهم رسول الله’.
ليس هناك اتفاق بين المؤرِّخين على المدَّة التي بقي فيها السبايا بعد المعركة في الكوفة أو في بلاد الشام.
حصل الاختلاف في سنة وفاتها، مثلما حصل في سنة ولادتها‘، ولكنَّ الأرجح لديَّ أنَّه كان سنة 62 هـ.
وتبع الاختلاف في تأريخ وفاتها اختلاف المؤرِّخين في مكان دفن جسدها الطاهر، وانقسم المؤرِّخون في أربعة اتجاهات؛ في سنجار، ومصر، وبلاد الشام والمدينة المنورة، وقد رجَّحتُ أن تكون المدينة المنورة هي مرقدها بعد مناقشة كلّ اتجاه من تلك الإتجاهات التي ذهب إليها المؤرِّخون.
- القرآن الكريم.
ـ الأبشيهي، شهاب الدين محمد بن احمد بن ابي الفتح (ت850 هـ)
1. المحلى، طـ مصر، 1368هـ.
ـ ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد المدائني (ت656هـ)
2. شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2 مصر، 1965.
ـ ابن أعثم، أبو محمد أحمد الكوفي (ت 314 هـ)
3. مقتل الحسين وثورة المختار، طـ2 إيران، 2004.
4. كتاب الفتوح، تحقيق علي شيري، طـ بيروت، 1991.
ـ ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت630هـ)
5. الكامل في التأريخ، عني بمراجعته نخبة من العلماء، ط2 بيروت، 1980.
6. أسد الغابة في معرفة الصحابة، طـ طهران، بلا. ت.
ـ ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا (ت 701 هـ)
7. الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية، مراجعة محمد عوض ابراهيم بك وعلي الجارم، ط2 مصر، بلا. ت.
ـ ابن العديم، كمال الدين عمر بن احمد بن ابي جرادة الحلبي (ت 660هـ)
8. ترجمة الامام الحسين، تحقيق: محمد الطباطبائي، طـ1 قم، 2002.
ـ ابن بطوطة، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة (ت 770 هـ)
9. رحلة بن بطوطة، مصر، الأزهرية، 1928.
ـ ابن بكار، الزبير (ت 256 هـ)
10. الاخبار والموفقيات، تحقيق سامي مكي العاني، طـ بغداد، 1972.
ـ ابن تغري بردى، جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 874 هـ)
11. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، طـ مصر، 1963.
ـ ابن جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني (ت 614 هـ)
12. رحلة ابن جبير تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، طـ مصر، بلا. ت.
ـ ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد (ت 241 هـ)
13. الورع، طـ مصر، 1340هـ.
ـ ابن خياط، خليفة العصفري (ت قبل 240هـ)
14. تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أكرم ضياء العمري، طـ1 النجف الاشرف، 1967.
ـ ابن زكريا، أبو الحسن احمد بن فارس (ت 395هـ)
15. معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، طـ مصر، بلا. ت.
ـ ان سعد، محمد (ت230هـ)
16. الطبقات الكبرى، ترجمة الإمام الحسين ومقتله من القسم الغير مطبوع، تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي، القاهرة، بلا· ت.
17. الطبقات الكبرى، راجعه وعلق عليه سهيل كيالي، ط بيروت، 1994.
ـ ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر الحسيني (ت 664 هـ)
18. اللهوف على قتل الطفوف، طـ قم، 1981.
ـ ابن طباطبا، أبو المعمر يحيى بن محمد بن القاسم الحسني (ت 478 هـ)
19. أبناء الإمام في مصر والشام، تحقيق محمد نصار ابراهيم، طـ القدس، 1934.
ـ ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر (380 هـ)
20. بلاغات النساء، تقديم أحمد الألفي، طـ مصر، 1987.
ـ ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد المالكي (ت463هـ)
21. الاستيعاب في أسماء الأصحاب، طـ مصر، 1939.
ـ ابن عبد ربه، أبو عمر احمد بن محمد الاندلسي (ت 328 هـ)
22. العقد الفريد، شرحه وضبطه وصححه أحمد أمين وآخرون طـ 2 مصر، 1962.
ـ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت 571 هـ)
23. تهذيب تاريخ دمشق الكبير، هذبه ورتبه عبد القادر بدران، طـ2 بيروت، 1979.
ـ ابن عقدة الكوفي، أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد (ت332هـ)
24. فضائل أمير المؤمنين×، قدم له عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين، طـ1 قم، 2003.
ـ ابن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي (ت828هـ)
25. عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب، ط بغداد، 1988.
ـ ابن فندق، أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن زيد البيهقي (ت 565هـ)
26. لباب الأنساب والألقاب، تحقيق: مهدي الرجائي، طـ طهران، 1990.
ـ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (تاريخ 276 هـ)
27. عيون الأخبار، طـ مصر، 1963.
ـ ابن كثير، أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت 774 هـ)
28. البداية والنهاية، طـ مصر، بلا. ت.
ـ ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت 275 هـ)
29. تأريخ الخلفاء، تحقيق محمد فصيح الحافظ، طـ2 بيروت، 1986.
30. سنن ابن ماجة، طـ بيروت، 2000.
ـ ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711هـ)
31. لسان العرب، طـ1 بيروت، 1300هـ.
ـ ابن نما، جعفر بن محمد بن جعفر الحلي (من أعلام القرن السابع الهجري)
32. ذوب النضار في شرح الثار، طـ قم، 1996.
ـ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري (ت218هـ)
33. سيرة إبن هشام، علق عليه عبد الرؤوف سعد، ط بيروت، 1975.
ـ أبو السعود، صلاح
34. الشيعة النشأة السياسية والعقيدة الدينية، طـ 2 القاهرة، 2004.
ـ أبو النصر، عمر
35. الحسين بن علي حفيد محمد بن عبد الله، ط بيروت، 1934.
36. فاطمة بنت محمد، طـ القاهرة، 1947.
ـ أبو سعيدة، حسين
37. هكذا أنت يا بطلة كربلاء، طـ3 النجف الاشرف، 2003.
ـ أبو عبيد، عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت 487 هـ)
38. معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، طـ3 القاهرة، 1996.
ـ أبو نعيم الأصفهاني، أحمد بن عبد الله (ت 430 هـ)
39. دلائل النبوة، طـ2 بيروت، 1985.
ـ الأربلي، أبو الحسن علي بن عيسى (ت 692هـ)
40. كشف الغمة، قدم له أحمد الحسيني، طـ قم، 1951.
ـ الأزورقاني، عزالدين أبو طالب اسماعيل بن الحسين بن محمد المروزي (ت بعد 614هـ)
41. الفخري في أنساب الطالبيين، تحقيق: مهدي الرجائي، ط قم، 1990.
ـ الأصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت 356هـ)
42. مقاتل الطالبيين، قدم له وأشرف عليه: كاظم المظفر، طـ النجف الاشرف، 1965.
ـ بحر العلوم، محمد
43. في رحاب السيدة زينب، طـ بيروت، 1975.
ـ البحراني، حسين بن محمد بن أحمد بن عصفور
44. كتاب الوفيات، طـ بيروت، بلا. ت.
ـ البخاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل (ت 256هـ)
45. صحيح البخاري، طـ1 بيروت، 2001.
ـ البغدادي، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي (ت 245هـ)
46. المحبر، صحح الكتاب، ايلزة ليختن شتيتر، طـ بيروت، بلا. ت.
ـ البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279 هـ)
47. أنساب الأشراف، تحقيق محمد باقر المحمودي، طـ1 بيروت، 1977.
ـ بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن
48. بطلة كربلاء زينب بنت الزهراء، طـ بيروت، 1961.
ـ البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين (ت458 هـ)
49. دلائل النبوة وأحوال صاحب الشريعة، وثّق أصوله عبد المعطي قلعجي، طـ بيروت، 1985.
ـ الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت297هـ)
50. سنن الترمذي، طـ1 بيروت، 2000.
ـ التنوخي، أبو علي المحسن بن علي (ت 384 هـ)
51. المستجاد من فعلات الأجواد، تحقيق محمد كرد علي، 1970.
ـ الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 هـ)
52. البرصان والعرجان والعميان والحولان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، طـ بغداد، 1982.
ـ الجصاني، صالح
53. الصديقة الصغرى زينب بنت علي، مراجعة عبد الجبار الساعدي.
ـ الجنحاني، الحبيب
54. التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الاسلام، طـ بيروت، 1985.
ـ الحداد، عبد السادة محمد
55. الملحمة الحسينية، طـ 2 بيروت، 2002.
ـ حسن، علي إبراهيم
56. نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب، طـ القاهرة، 1963.
ـ الحسني، هاشم معروف
57. الانتفاضات الشيعية في التأريخ، طـ2 قم، 1983.
ـ الحنفي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد بن حجة الحموي (ت هـ)
58. ثمرات الأوراق في المحاضرات، طـ مصر، 1368.
ـ خالد، خالد محمد
59. رجال حول الرسول، طـ2 بيروت، 1973.
ـ الخضري بك، محمد
60. نور اليقين في سيرة سيد المرسلين، طـ دمشق، بلا. ت.
ـ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي (ت 463 هـ)
61. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، طـ مكة المكرمة، بلا. ت.
ـ الخوئي، أبو القاسم الموسوي
62. معجم رجال الحديث النجف، 1978.
ـ الخوارزمي، الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت 568هـ)
63. المناقب، طـ4 قم، 1999.
ـ الدميري، كمال الدين محمد بن موسى (ت 682 هـ)
64. حياة الحيوان الكبرى، عنى بتصحيحه عبد اللطيف سامر، طـ1 قم، 2004.
ـ الدولابي، أبو بشير محمد بن أحمد الانصاري (ت 310 هـ)
65. الذرية الطاهرة، تحقيق محمد جواد الجلالي، طـ قم، 1986.
ـ الديار بكري، حسين محمد (ت 982 هـ)
66. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، طـ مصر، بلا. ت.
ـ الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود (ت 282 هـ)
67. الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، طـ2 قم، 1977.
ـ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ)
68. سير أعلام النبلاء، تحقيق: صلاح الدين المنجد، طـ مصر، بلا. ت.
ـ رباني، حاج شيخ علي
69. حسين بن علي×، طـ6 قم،، باللغة الفارسية2000.
ـ الريشهري، محمد
70. موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتأريخ، طـ قم، 2001.
ـ زعرور، إبراهيم وعلي أحمد
71. ـ تاريخ العصر الأموي السياسي والحضاري، طـ دمشق، 2004.
ـ السابقي، محمد حسنين
72. مرقد العقيلة في ميزان الدراسة والتحقيق، تحقيق: صفدر عباس السابقي، طـ2 إيران 2001.
ـ الساعدي، عبد الجبار
73. الصديقة الصغرى زينب بنت علي.
ـ سبط ابن الجوزي، أبو المظفر يوسف شمس الدين (ت 654 هـ)
74. تذكرة الخواص، طـ النجف الأشرف، 1369هـ.
ـ سبهر، لسان الملك ميرزا محمد تقي
75. ناسخ التواريخ في أحوال حضرة سيد الشهداء×، مراجعة: نخبة من العلماء، طـ 4، طهران، 2000.
ـ السخاوي، شمس الدين (ت902هـ)
76. التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة، طـ مصر، 1957.
ـ السماوي، محمد طاهر
77. إبصار العين في أنصار الحسين، تحقيق محمد جعفر الطبسي، طـ قم، 1998.
ـ سيد الأهل، عبدالعزيز
78. زينب بنت علي، طـ2 القاهرة، 1961.
ـ السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت 911هـ)
79. تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، طـ مصر، بلا. ت.
ـ الشافعي، أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة النصيبي (ت652هـ)
80. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، تحقيق ماجد أحمد العطية، طـ1 بيروت، 1999.
ـ الشاكري، حسين
81. العقيلة زينب والفواطم، طـ إيران، 2001.
ـ الشبلنجي، مؤمن بن حسن (من علماء القرن13هـ)
82. نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، طـ بيروت، بلا. ت.
ـ شرف الدين، عبد الحسين
83. الفصول المهمة في تأليف الأمة، تحقيق عبد الجبار شرارة، طـ3 دمشق، 1999.
ـ الشرواني، حيدر علي بن محمد (من اعلام القرن الثاني عشر الهجري)
84. ماروته العامة من مناقب أهل البيت، تحقيق: محمد الحسون، ط2 قم، 1996.
مناقب أهل البيت، تحقيق محمد الحسون، قم، 1994.
ـ شلبي، أحمد
85. الدولة الأموية، طـ القاهرة، 1981.
86. ابنة الزهراء زينب، طـ مصر، بلا. ت.
ـ شمس الدين، محمد مهدي
87. ثورة الحسين ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية، طـ6 بيروت، 1981.
ـ الشهرستاني، هبة الدين
88. نهضة الحسين، طـ النجف الأشرف، 1978.
ـ الصبان، محمد بن علي (ت1250هـ)
89. اسعاف الراغبين في سيرة المصطفين وفضائل أهل بيته الطاهرين، طـ بيروت، بلا. ت.
ـ صبيح، محمود السيد
90. خصوصية وبشرية النبي عند قتلة الحسين، طـ القاهرة، 2005.
ـ الصدر، محمد محمد صادق
91. شذرات من فلسفة تاريخ الإمام الحسين×، تقريرات أسعد الناصري، ط بيروت، 2002.
ـ الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت 381هـ)
92. الأمالي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، طـ قم، 1417 هـ.
93. كمال الدين وتمام النعمة، طـ2 طهران، 1395هـ.
ـ الطبراني، الحافظ سليمان بن أحمد (ت 360 هـ)
94. المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، طـ 2 مصر، بلا. ت.
ـ الطبرسي، أبو على الفضل بن الحسن من (أعلام القرن السادس الهجري)
95. اعلام الورى بأعلام الهدى، قدم له محمد مهدى الخرسان، طـ النجف الاشرف، 1970.
ـ الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي (من علماء القرن السادس الهجري)
96. الاحتجاج، طـ بيروت، بلا. ت.
ـ الطبري، عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم (كان حيا حتى عام 553 هـ)
97. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، تحقيق جواد القيومي، طـ2 قم، 2002.
ـ الطبري، محمد بن جرير (310هـ)
98. تأريخ الرسل والملوك، تحقيق: نخبة من العلماء، ط بيروت، 1979.
99. استشهاد الحسين، تحقيق السيد الجميلي، طـ2 بيروت، 1997.
ـ الطبسي، نجم الدين
100. الإمام الحسين في مكة المكرمة، ط قم، 2001.
ـ الطبسي، محمد جعفر
101. وقائع الطريق من كربلاء إلى الشام، طـ قم، 1382 هـ.
ـ الطريحي، فخر الدين (ت1085 هـ)
102. المنتخب في المراثي والخطب، طـ3 النجف الاشرف، 1949.
ـ الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن (ت 460 هـ)
103. الغيبة، طـ قم، بلا. ت.
ـ عابدين، محمد علي
104. الدوافع الذاتية لأنصار الحسين، طـ3 قم، 1983.
ـ عبد الآخر، أبو الوفا أحمد
105. التآمر على التأريخ الإسلامي، طـ القاهرة، 1990.
ـ عبد الحميد، صائب
106. تأريخ الإسلام الثقافي والسياسي، طـ قم، 1997.
ـ عبد الحميد، محمد محي الدين، والسبكي، محمد عبد اللطيف
107. المختار من صحاح اللغة، طـ القاهرة، 1934.
ـ عبد العليم، محمد محمود
108. سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، طـ القاهرة، 1977.
ـ العبيدلي، يحيى بن الحسن بن جعفر (ت277هـ)
109. السيدة زينب وأخبار الزينبات تحقيق: حسن محمد قاسم، طـ2 مصر، 1934.
ـ عثمان، حافظ
110. الإسلام والصراعات الدينية، طـ مصر، 1994.
ـ العلايلي، عبد الله
111. الإمام الحسين أيام الحسين عرض وقصص، طـ بيروت، بلا. ت.
ـ العلوي، هادي
112. الاغتيال السياسي في الإسلام، طـ بيروت، 1987.
ـ علي، موسى محمد
113. عقيلة الطهر والكرم السيدة زينب (رضي الله عنها)، طـ مصر، بلا. ت.
ـ عيش، احمد محمد
114. صوت الحسين، طـ مصر، 1963.
ـ غريب، مأمون
115. بطلة كربلاء السيدة زينب، طـ مصر، 1999.
ـ غلامي، حسين غيب
116. احراق بيت فاطمة، طـ2 بيروت، 2000.
ـ الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 817هـ)
117. القاموس المحيط، طـ بيروت، 1991.
ـ القرشي، باقر شريف
118. السيدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام عرض وتحليل، طـ النجف، 1414هـ.
ـ القرطبي، شمس الدين ابو عبد الله الأنصاري (ت 671 هـ)
119. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، طـ بيروت، 1986.
ـ القزويني، رضي بن نبي
120. تظلم الزهراء، طـ2 النجف، 1962.
ـ القزويني، محمد كاظم
121. زينب الكبرى من المهد إلى اللحد، تحقيق: مصطفى القزويني، طـ3 إيران، 2002.
ـ القطيفي، عبد المحسن عبد الزهرة
122. المحسن بن فاطمة الزهراء، طـ 5 دمشق، 2000.
ـ القطيفي، فرج آل عمران
123. وفاة زينب الكبرى، طـ النجف، 1959.
ـ القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي (ت 821 هـ)
124. صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تقديم وتصويب محمد عبد القادر حاتم، طـ مصر، 1963.
ـ القمي، أبو الفضل سديد الدين شاذان بن جبرئيل (من اعلام القرن السادس الهجري)
125. الفضائل، تحقيق: محمود البدري، ط قم، 1981.
ـ القندوزي، الحافظ سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي (1220 ـ 1294 هـ)
126. ينابيع المودة، ط 7، الحيدرية، نجف، 1965.
ـ كحالة، عمر رضا
127. أعلام النساء، طـ 2 دمشق، 1985.
ـ لجنة نشر العلوم والمعارف
128. السيدة زينب، طـ إيران، 2001.
ـ المازندراني، محمد مهدي
129. معالي السبطين، ط النجف الاشرف، 1960.
ـ الإمام مالك، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك (ت 179 هـ)
130. الموطأ، رواية يحيى بن يحيى المصمودي، تقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي، طـ، بيروت، 1997.
ـ المامقاني، عبد الله
131. تنقيح المقال، طـ النجف الأشرف، 1352هـ.
ـ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت 450 هـ)
132. أدب الدين والدنيا، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، طـ مصر، 1993.
ـ المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد النحوي (ت285هـ)
133. الكامل في اللغة، طـ بيروت، 1985.
ـ المجلسي، محمد باقر (ت 111 هـ)
134. بحار الأنوار، تعليق جواد العلوي ومحمد الآخوند، طـ 3 إيران، 1342هـ.
ـ محلاتي، هاشم رسول
135. أضاءات من حياة حضرة فاطمة الزهراء وزينب الكبرى، طـ9 ايران، 2002.
ـ محمد، احمد فهمي
136. ذكرى العقيلة، ط القاهرة، بلا. ت.
ـ المدني، أبو الحسين بن الحسن بن جعفر (ت 214 هـ)
137. المعقبين من ولد الإمام أمير المؤمنين، تحقيق محمد الكاظم، طـ قم، 2001.
ـ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت346هـ)
138. التنبيه والإشراف، عني بتصحيحه ومراجعته عبد الله إسماعيل الصاوي، طـ مصر، 1993.
139. مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق: سعيد محمد اللحام / ط بيروت، 2000.
ـ الإمام مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ)
140. صحيح مسلم، طـ1 بيروت، 2000.
ـ مغنية، محمد جواد
141. الحسين وبطلة كربلاء، طـ النجف الأشرف، بلا. ت.
ـ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، (ت413هـ)
142. الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، ط طهران بلا. ت.
ـ المقدسي، أبو زيد أحمد بن سهل البلخي (ت 387 هـ)
143. البدء والتاريخ، طـ مصر، 1916.
ـ المقرم، عبد الرزاق
144. مقتل الحسين، طـ2 النجف الأشرف، 1956.
ـ المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد (ت 845 هـ)
145. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)، طـ مصر، 1324.
ـ الموسوي، عبد الرسول
146. الشيعة في التأريخ، طـ2، القاهرة.
ـ النسائي، أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب (ت 203 هـ)
147. سنن النسائي، طـ بيروت، بلا. ت.
148. خصائص علي بن أبي طالب (رض الله عنه)، تحقيق: محمد الكاظم، طـ1 قم، 1998.
ـ النصراوي، حسين عبد الأمير
149. رأس الحسين× من الشهادة إلى الدفن، طـ1 بيروت، 2000.
ـ النقدي، جعفر النقدي (ت 1370هـ)
150. زينب الكبرى بنت الإمام علي بن أبي طالب، طـ إيران.
ـ النووي، ابن زكريا حي الدين بن شرف (ت 676 هـ)
151. تهذيب الأسماء واللغات، طـ مصر، بلا. ت.
ـ النويري، شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت733هـ)
152. نهاية الإرب في فنون الأدب، طـ2 مصر، 1928.
ـ الهاشمي، علي بن الحسين
153. عقيلة بني هاشم، طـ النجف الأشرف، 1967.
ـ الواثقي، حسين
154. جابر بن عبد الله الانصاري حياتهُ ومُسنده، طـ إيران، 1378 هـ.
ـ الواقدي، محمد بن عمر بن واقد (ت 207هـ)
155. المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، طـ إيران، 1994.
ـ اليافعي، ابو محمد عبد الله بن أسعد بن علي المكي (ت768هـ)
156. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، طـ بيروت، 1970.
ـ ياقوت، شهاب الدين بن عبد الله الحموي (ت 626 هـ)
157. معجم البلدان، ط بيروت، 1977.
ـ يعقوب، أحمد حسين
158. النظام السياسي في الإسلام، طـ لندن، 1992.
ـ اليعقوبي، أحمد بن أسحق بن جعفر بن وهب (ت292هـ)
تأريخاليعقوبي، علقعليهخليلالمنصور، طـ بيروت 1999.
ـ البصير، محمد مهدي
159. الثبات في المبدأ، مجلة البطحاء، الناصرية، العدد 14، السنة الأولى، 1946.
ـ الثعاليبي، يحيى كاظم
160. المروءة الحسينية، مجلة الميزان، العمارة، العدد 28، السنة الرابعة، 1367 هـ.
ـ جلال، محمود جواد
161. الصراع بين الحق والباطل، مجلة الميزان، العمارة، العدد 28.
ـ الحساني، محمد رضا
162. الحسين بن علي، مجلة القادسية، النجف الأشرف، العدد 5، السنة الرابعة، 1366هـ.
ـ خفاجي، محمد عبد المنعم
163. من الذكرى الخالدة، مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 2، السنة الخامسة عشرة، 1953.
ـ زيادة، محمد مصطفى
164. الحسين في التأريخ، مجلة البيان، النجف الأشرف، العدد 11-14، السنة الأولى، 1947.
ـ الشهرستاني، هبة الدين الحسيني
165. زينب في عاصمة أبيها، مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 9 و10، السنة الثامنة، 1947.
ـ الطيباوي، عبد اللطيف
166. محاضرات في تأريخ العرب والإسلام، طـ بيروت، 1963.
ـ الفكيكي، توفيق
167. مكانة النهضة الحسينية في تأريخ القومية العربية، مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 9-10، السنة الثامنة، 1947.
ـ المختار، عبد الهادي
168. لماذا قتل الحسين×، مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 9 و10، السنة الثامنة، 1947.
ـ المظفر، عبد العالي
169. الفتح والاستشهاد في ذكرى الحسين×، مجلة الأضواء، النجف الأشرف، العدد 3، السنة السادسة، 1966.
ـ الوردي، علي
170. حركة الحسين ومراميها، مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 9 و11، السنة الخامسة، 1944.
ـ التميمي، هادي عبد النبي محمد
171. الدور اليهودي في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية عصر الرسول’،
172. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2001.
ـ الجمل، وحيد عبد الحكيم
173. سيرة الحسين في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي الأول، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، 1980.
[1] البقرة: آية31.
[2] الفيض الكاشاني، محمّد، المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء: ج1، ص 111.
[3] المجادلة: آية11.
[[4]][4] البقرة: آية129.
[5] آل عمران: آية164.
[6] الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
[7] البقرة: آية253.
[8] ابن سعد، محمد (ت230هـ)، الطبقات الكبرى، راجعه وعلَّق عليه سهيل كيالي، ط بيروت، 1994: ج4، ص314؛ العبيدلي، يحيى بن الحسن بن جعفر (ت277هـ)، السيدة زينب وأخبار الزينبات تحقيق: حسن محمد قاسم، ط ـ 2 مصر، 1934: ص30؛ الطبري، محمد بن جرير (310هـ)، تأريخ الرسل والملوك، تحقيق: نخبة من العلماء، ط بيروت، 1979: ج4، ص117؛ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان، (ت413هـ)، الارشاد في معرفة حجج الله على العباد، ط طهران بلا. ت: ج 1، ص 2.
[[9]][9] ابن هشام، أبو محمد عبد الملك المعافري (ت218هـ)، سيرة ابن هشام، علَّق عليه: عبد الرؤوف سعد، ط بيروت، 1975: ج1، ص403؛ اليعقوبي، أحمد بن أسحق بن جعفر بن وهب (ت292هـ)، تأريخ اليعقوبي، علَّق عليه: خليل المنصور، ط ـ بيروت 1999: ج2، ص80؛ المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت346هـ)؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق: سعيد محمد اللحام، ط بيروت،2000: ج2، ص270، السخاوي، شمس الدين (ت902هـ)، التحفة اللطيفة في تأريخ المدينة الشريفة، ط ـ مصر، 1957: ج1، ص9.
[10] ابن سعد، الطبقات: ج4، ص296؛ ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت630هـ)، الكامل في التأريخ، عني بمراجعته: نخبة من العلماء، ط2 بيروت، 1980: ج3، ص199؛ ابن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد المدائني (ت656هـ)، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط2 مصر، 1965: ج1، ص11.
[11] ابن سعد، الطبقات: ج4، ص36؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص199؛ الشافعي، أبو سالم كمال الدين محمد بن طلحة النصيبي (ت652هـ)، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، تحقيق ماجد أحمد العطية، ط ـ 1 بيروت، 1999: ج1، ص57.
[12]الشافعي، مطالب السؤول: ج1، ص57.
[13] ابن أبي الحديد، شرح النهج: ج1، ص13.
[14] ابن عقدة الكوفي، أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد (ت332هـ)، فضائل أمير المؤمنين×، قدم له عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين، ط ـ 1 قم، 2003: ص11.
[15] ابن عنبة، جمال الدين احمد بن علي (ت828هـ)، عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب، ط بغداد، 1988: ج2، ص58؛ القمي، أبو الفضل سديد الدين شاذان بن جبرئيل (من اعلام القرن السادس الهجري)، الفضائل، تحقيق: محمود البدري، ط قم، 1981: ص 124؛ الشافعي، مطالب السؤول: ج1، ص51؛ ابن أبي الحديد، شرح النهج: ج1، ص14.
[16] ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا (ت 701 هـ)، الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية، مراجعة: محمد عوض ابراهيم بك وعلي الجارم، ط2 مصر، بلا. ت: ص88، الابشيهي، شهاب الدين محمد بن احمد بن ابي الفتح (ت850 هـ)، المحلى، ط ـ مصر، 1368هـ: ج1، ص221.
[17]المقدسي، أبو زيد احمد بن سهل البلخي (ت 387 هـ)، البدء والتاريخ، ط ـ مصر، 1916: ج5، ص73، ابن ابي الحديد، شرح النهج: ج1، ص15.
[18] ابن سعد، طبقات: ج6، ص14؛ الأزورقاني، عزالدين ابو طالب اسماعيل بن الحسين بن محمد المروزي (ت بعد 614هـ)، الفخري في انساب الطالبيين، تحقيق: مهدي الرجائي، ط قم، 1990: ص8.
[19] ابن هشام، السيرة: ج1، ص175.
[20] ابن سعد، الطبقات: ج6، ص49.
[21]ينظر في مناقب فاطمة‘: البخاري، أبو عبدالله محمد بن اسماعيل (ت 256هـ)، صحيح البخاري، ط ـ 1 بيروت، 2001: ص660ـ661؛ الإمام مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ) صحيح مسلم، ط ـ 1 بيروت، 2000: ص1056ـ1058؛ الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت297هـ)، سنن الترمذي، ط ـ 1 بيروت، 2000: ص992؛ النسائي، أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب (ت 303هـ)، خصائص علي بن أبي طالب، تحقيق: محمد الكاظم، ط ـ 1 قم، 1989، ص 157ـ167ـ202؛ الشافعي، مطالب السؤول: ج1، ص31ـ45؛ الشرواني، حيدر علي بن محمد (من اعلام القرن الثاني عشر الهجري)، ماروته العامة من مناقب أهل البيت، تحقيق: محمد الحسون، ط2 قم، 1996: ص229ـ239؛ عليان، عدنان، الشيعة والدولة العراقية الحديثة، ط ـ بيروت، 2005: ص 45 ـ 46.
[22]ينظر في ترجمة الإمام الحسن×: اليعقوبي، تاريخ: ج2، ص150؛ المسعودي، مروج الذهب: ج2، ص5؛ السيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر (ت 911هـ)، تاريخ الخلفاء، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، ط ـ مصر، بلا. ت: ص189.
[23]ينظر في ترجمة الإمام الحسين×: ابن فندق، أبو الحسن علي بن ابي القاسم بن زيد البيهقي (ت 565هـ)، لباب الانساب والالقاب، تحقيق: مهدي الرجائي، ط ـ طهران، 1990: ص245؛ ابن العديم، كمال الدين عمر بن احمد بن أبي جرادة الحلبي (ت 660هـ)، ترجمة الامام الحسين، تحقيق: محمد الطباطبائي، ط ـ 1 قم، 2002؛ الإربلي، أبو الحسن علي بن عيسى (ت 692هـ)، كشف الغمة، قدم له أحمد الحسيني، ط ـ قم، 1951: ج1، ص550ـ551.
[24] ابن سعد، الطبقات: ج4، ص312؛ الطبري، ذخائر العقبى: ص177؛ المجلسي، محمد باقر (ت 111 هـ)، بحار الأنوار، تعليق جواد العلوي ومحمد الاخوند، ط ـ 3 إيران، 1342هـ، 42، ص91.
(*)محمد بن الحنفية: ابن علي بن أبي طالب، ويقال كانت أمه من سبي اليمامة فصارت إليه، وقيل إن الرسول | قال لعلي× (انه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلتهُ اسمي وكنيّته ولا تحلُّ لأحد من أمتي بعده)، ابن سعد، الطبقات: ج3، ص328ـ329.
[25]اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص148؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص74؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص270؛ الإربلي، كشف الغمة: ج1، ص419.
[26]المدني، أبو الحسين بن الحسن بن جعفر (ت 214 هـ)، المعقبين من ولد الإمام أمير المؤمنين، تحقيق: محمد الكاظم، ط ـ قم، 2001 م: ص 58؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص148؛ الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص118؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص74؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص200.
[27]وقيل إنهما قُتلا في الطف مع الإمام الحسين×، وقيل : إنَّ عبيد الله قتله المختار بالمذار، ولا بقية لهم، الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص118؛ ابن الاثير، الكامل: ج3، ص200.
[28]أمُّهما الصهباء بنت ربيعة، سُبيت في خلافة أبي بكر وإمارة خالد بن الوليد لعين التمر، فاشتراها علي×، واعتقها وتزوج بها، ابن فندق، لباب الأنساب: ج1، ص336.
[29]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص119؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص74؛ ابن الاثير، الكامل: ج3، ص27، وزاد ابن الاثير اختاً أخرى لزينب‘ هي أمُّ كلثوم وأمُّها أمُّ سعيد.
[30]البغدادي، أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي (ت 245هـ) المحبر، صحح الكتاب، ايلزة ليختن شتيتر، ط ـ بيروت، بلا. ت: ص 56ـ57؛ الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص119؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص74.
[31]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص119؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص200.
[32]العبيدلي، السيدة زينب: ص30؛ بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن، بطلة كربلاء زينب بنت الزهراء، ط ـ بيروت، 1961: ص27؛ كحاله، عمر رضا، أعلام النساء، ط2 دمشق، 1958: ص91؛ القزويني، زينب الكبرى من المهد إلى اللحد، تحقيق: مصطفى القزويني، ط ـ 3 إيران، 2002: ص31، غريب، مأمون، بطلة كربلاء السيدة زينب، ط ـ مصر، 1999: ص11.
[33]القطيفي، فرج آل عمران، وفاة زينب الكبرى، ط ـ النجف، 1959: ص2؛ النقدي، جعفر الربعي (ت 1370هـ)، زينب الكبرى بنت الإمام علي بن أبي طالب، ط ـ إيران بلا. ت: ص 17، الشاكري، حسين، العقيلة زينب والفواطم، ط ـ إيران، 2001: ص10.
[34]النقدي، زينب الكبرى: ص17.
[35]القرشي، باقر شريف، السيدة زينب رائدة الجهاد في الإسلام عرض وتحليل، ط ـ النجف، 1414هـ: ص37.
[36]الواقدي، محمد بن عمر بن واقد (ت 207هـ)، المغازي، تحقيق: مارسدن جونس، ط ـ إيران، 1994: ج1، ص7؛ ابن خياط، خليفة العصفري (ت قبل 240هـ)، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق: أكرم ضياء العمري، ط ـ 1 النجف الاشرف، 1967: ص60؛ المسعودي، مروج الذهب: ج2، ص293.
[37]القرشي، السيدة زينب رائدة الجهاد: ص37.
[38]القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي (ت 821 هـ): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، تقديم وتصويب محمد عبد القادر حاتم، ط ـ مصر، 1963: ج5، ص423.
[39]المازندراني، محمد مهدي، معالي السبطين، ط النجف الاشرف، 1960، مجلد 1: ج1، ص685، سيد الأهل، عبدالعزيز، زينب بنت علي، ط ـ 2، القاهرة، 1961: ص7.
[40]غريب، بطلة كربلاء: ص 17ـ 18.
[41]القلقشندي، صبح الأعشى: ج5، ص424ـ425.
[42] ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711هـ)، لسان العرب، ط ـ 1 بيروت، 1300هـ، مادة (زنب).
[43] ابن زكريا، أبو الحسن احمد بن فارس (ت 395هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط ـ مصر، بلا. ت: ج3، ص41؛ الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب (ت 817هـ)، القاموس المحيط، ط ـ بيروت، 1991: ج1، ص220.
[44] ابن زكريا، معجم مقاييس: ج3، ص41.
[45]عبد الحميد، محمد محي الدين، والسبكي، محمد عبد اللطيف، المختار من صحاح اللغة، ط ـ القاهرة، 1934: ص223.
[46]محلاتي، هاشم رسول، أضاءات من حياة حضرة فاطمة الزهراء وزينب الكبرى، ط ـ 9 ايران، 2002: ص66، باللغة الفارسية.
[47]السابقي، محمد حسنين، مرقد العقيلة في ميزان الدراسة والتحقيق، تحقيق: صفدر عباس السابقي، ط ـ 2 إيران 2001: ص101.
[48] ابن سعد، الطبقات: ج4، ص312؛ الطبري، محب الدين أحمد بن عبد الله (ت 694 هـ)، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، ط ـ مصر، 1356 هـ: ص177.
[49]القطيفي، وفاة زينب: ص4 ؛ القزويني، زينب: ص38، القرشي، السيدة زينب: ص35؛ النقدي، زينب الكبرى: ص16، على الرغم من أنَّه لم يؤكِّد ذلك؛ الجصاني، صالح، الصديقة الصغرى زينب بنت علي، مراجعة عبد الجبار الساعدي، بلا. ت: ص18.
[50] ابن عنبه، عمدة الطالب: ج2، ص100.
[51]القلقشندي، صبح الأعشى: ج5، ص438.
[52] ابن زكريا، معجم مقاييس: ج4، ص72؛ عبد الحميد، المختار: ص351.
[53] ابن منظور، لسان العرب، مادة (عقل).
[54] ابن زكريا، معجم مقاييس: ج4، ص73.
[55]الاصفهاني، أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت 356هـ)، مقاتل الطالبيين، قدَّم له وأشرف عليه: كاظم المظفر، ط ـ النجف الاشرف، 1965: ص60.
[56] ابن منظور، لسان العرب، مادة (عبد).
[57]المصدر نفسه، مادة (عبد).
[58]المصدر نفسه، مادة (فضل)؛ عبد الحميد، المختار: ص398.
[59]عبد الحميد، المختار: ص398.
[60]الفيروز آبادي، القاموس المحيط: ج4، ص62؛ عبد الحميد، المختار: ص458.
[61]الطبرسي، أبو منصور احمد بن علي (من علماء القرن السادس الهجري)، الاحتجاج، ط ـ بيروت، بلا. ت: ج2، ص196.
[62]محمد، احمد فهمي، ذكرى العقيلة، ط القاهرة، بلا. ت: ص4.
[63]الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب (ت 450 هـ)، أدب الدين والدنيا، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، ط ـ مصر، 1993» 292.
[64]آل عمران، آية200.
[65]الصدر، محمد محمد صادق، شذرات من فلسفة تاريخ الإمام الحسين×، تقريرات أسعد الناصري، ط بيروت، 2002: ص140.
[66]سيد الأهل، زينب: ص18ـ19؛ الصدر، شذرات من فلسفة تاريخ الإمام الحسين×: ص 141.
[67] الصدر، شذرات: ص140.
[68] الأحزاب، آية33.
[69]الطبري، ذخائر العقبى: ص300.
[70]تقول الرواية: إنَّ السيدة زينب‘ وهي في عمر مبكر رأت رؤيا أخافتها، فحدَّثت بها جدَّها الرسول | بأنها رأت ريحاً عاصفة قد انبعثت فاسودَّت الدنيا وما فيها، وأظلمت السماء فتمسَّكت بشجرة عظيمة لتسلم من شدة الريح، إلا أنَّ الريح اقتلعت تلك الشجرة ورمت بها على الأرض، فتمسَّكت بالقوي من أغصان تلك الشجرة فكسرتها الرياح، فتمسَّكت بأخرى فانكسرت، ثم استيقظت من نومها فزعة، فبكى الرسول | وقال: فأما الشجرة فهو جدُّكِ والغصنان الكبيران أمُّكِ وأبوكِ، والغصنان الآخران أخواكِ الحسنان، وستسودُّ الدنيا لفقدهم، النقدي، زينب الكبرى: ص18؛ القزويني، زينب من المهد: ص49.
[71]مغنية، محمد جواد، الحسين وبطلة كربلاء، ط ـ النجف الاشرف، بلا. ت: ص173.
[72]الترمذي، سنن الترمذي: ص1008.
[73]النقدي، زينب الكبرى: ص17.
[74]أمامة بنت أبي العاص: ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي، صهر رسول الله | وزوج ابنته زينب، وكان الرسول | يحبُّ أمامة ويحملها معه إلى الصلاة، تزوَّج بها أمير المؤمنين× في خلافة عمر، وبقيت عنده مدة طويلة، وله منها أولاد، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 748هـ)، سير أعلام النبلاء، تحقيق: صلاح الدين المنجد، ط ـ مصر، بلا. ت: ج1، ص78ـ80.
[75]القطيفي، وفاة زينب: ص4، النقدي، زينب الكبرى: ص19.
[76] ابن أبي الحديد، شرح النهج: ج1، ص17؛ وللمزيد من فضائل وعلم أمير المؤمنين علي× يُنظر: البخاري، صحيح البخاري: ص658ـ660، في باب مناقب علي×؛ الترمذي، سنن الترمذي: ص977ـ983، في باب مناقب علي ايضاً؛ الخوارزمي، الموفق بن أحمد بن محمد المكي (ت 568هـ)، المناقب، ط ـ قم، 1999، إذ جمع الخوارزمي بين دفتي كتابه ما نقله المتقدمون من فضائله×.
(*) جعفر: ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمُّه فاطمة بنت أسد، يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج2، ص24؛ وهو ابن عمِّ النبي | الذي كان يكنيه بأبي المساكين، الاصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص3؛ هاجر إلى الحبشة فيمن هاجر إليها، ابن هشام السيرة: ج1، ص281؛ الخضري بك، محمد، نور اليقين في سيرة سيّد المرسلين، ط ـ دمشق، بلا. ت: ص63؛ وعاد منها إلى المدينة يوم فتح خيبر، وفي ذلك قال الرسول |: لا ادري بأيِّهما أنا أسرُّ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت346هـ)، التنبيه والأشراف، عني بتصحيحه ومراجعته: عبد الله إسماعيل الصاوي، ط ـ مصر، 1993: ص223، ابن أبي الحديد، شرح النهج، 15، ص72؛ خالد، خالد محمد، رجال حول الرسول، ط ـ 2 بيروت، 1973: ص80؛ التميمي، هادي عبد النبي محمد، الدور اليهودي في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية عصر الرسول |، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الكوفة، 2001: ص80؛ وقد استشهد جعفر في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة، وحزن عليه الرسول حزناً شديداً، ابن عنبة/ عمدة الطالب: ج2، ص35؛ اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي المكي (ت768هـ)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ط ـ بيروت، 1970: ج1، ص14، سبط ابن الجوزي، أبو المظفر يوسف شمس الدين (ت 654 هـ)، تذكرة الخواص، ط ـ النجف الأشرف، 1369هـ: ص197.
[77] ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم (ت 630 هـ)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ط ـ طهران، بلا. ت: ج5، ص469؛ المجلسي، بحار الأنوار، 42، ص93؛ بنت الشاطئ، بطلة كربلاء: ص49؛ الشهرستاني، هبة الدين الحسيني، زينب في عاصمة ابيها، بحث منشور في مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 9 و10، السنة الثامنة، 1947: ص 3.
[78]الشاكري، العقيلة: ص19.
[79] ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد المالكي (ت463هـ)، الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ط ـ مصر، 1939: ج2، ص266؛ سيد الاهل، زينب: ص23.
[80]القطيفي، وفاة زينب: ص5.
[81]النووي، ابن زكريا محيى الدين بن شرف (ت 676 هـ)، تهذيب الأسماء واللغات، ط ـ مصر، بلا. ت: ج1، ص263؛ منصور، محمد، الشقيقان في كربلاء، ط ـ 2 مصر، 1971: ص 27.
(*) أسماء بنت عميس: بن معد بن تيم بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن معاوية بن زيد بن مالك، وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحرث، أسلمت قبل دخول الرسول | دار الأرقم بمكة وبايعت وهاجرت مع زوجها جعفر إلى أرض الحبشة، ابن سعد، الطبقات: ج6، ص205؛ الخضري بك، نور اليقين في سيرة المرسلين؛ فولدت له هناك عبد الله ومحمد وعون، فلما استشهد جعفر تزوجها الخليفة أبو بكر فولدت له محمدا، البغدادي، المحبر: ص107ـ 108؛ مغنية، محمد جواد، جعفر بن أبي طالب، ط ـ النجف الأشرف، 1954، مجلد1: ج1، ص35؛ ثم خلف عليها أمير المؤمنين× فولدت له يحيى، اليعقوبي، تاريخ: ج2، ص148؛ المسعودي، مروج الذهب: ج2، ص174.
[82] ابن الأثير، أسد الغابة: ج3، ص133؛ النووي، تهذيب الأسماء: ج1، ص263؛ ابن عنبة، عمدة الطالب: ج2، ص37.
[83]سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص197؛ العسقلاني، الإصابة: ج2، ص280؛ شرف الدين، عبد الحسين، الفصول المهمة في تأليف الأمة، تحقيق: عبد الجبار شرارة، ط ـ 3 دمشق، 1999: ص 291.
[84] ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (ت 571 هـ)، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، هذبه ورتبه عبد القادر بدران، ط ـ 2 بيروت، 1979: ج27، ص357؛ ابن فندق، لباب الأنساب: ص198؛ العسقلاني، الاصابة: ج2، ص280.
[85]الحنفي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن محمد بن حجة الحموي (ت هـ)، ثمرات الأوراق في المحاضرات، ط ـ مصر، 1368: ص 85؛ للمزيد، يُنظر: ابن بكار، الزبير (ت 256 هـ)، الأخبار والموفقيات، تحقيق سامي مكي العاني، ط ـ بغداد، 1972: ص80 ـ 81؛ التنوخي، أبو علي المحسن بن علي (ت 384 هـ)، المستجاد من فعلات الأجواد، تحقيق محمد كرد علي، 1970، الصفحات 4، 11، 12، 13، 17، 20، 125، 203، 237.
[86]الديار بكري، حسين محمد (ت 982 هـ)، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، ط ـ مصر، بلا. ت: ج2، ص384.
[87] ابن سعد، الطبقات: ج6، ص314؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص200؛ الشبلنجي، مؤمن بن حسن (من علماء القرن13هـ)، نور الإبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، ط ـ بيروت، بلا. ت: ص183؛ الصبان، محمد بن علي (ت1250هـ) اسعاف الراغبين في سيرة المصطفين وفضائل أهل بيته الطاهرين، ط بيروت، بلا. ت: ص200؛ كحالة، أعلام النساء: ص 91.
[88]العبيدلي، السيدة زينب: ص35؛ بنت الشاطئ، بطلة كربلاء: ص49.
[89]النووي، تهذيب الاسماء: ج1، ص264.
[90]النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت733هـ)، نهاية الأرب في فنون الأدب، ط ـ 2 مصر، 1928، مجلد 2: ج2، ص341.
[91]يُنظر: المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد النحوي (ت285هـ)، الكامل في اللغة، ط ـ بيروت، 1985: ج2، ص154ـ 155؛ الساعدي، الصديقة الصغرى زينب بنت علي: ص46.
[92] ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص279؛ المسعودي، مروج الذهب: ج2، ص74؛ الطبري، ذخائر العقبى: ص231؛ ابن عنية، عمدة الطالب: ج2، ص135؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص75؛ اليافعي، مرآة الجنان: ج1، ص163.
[93] ابن الأثير، أسد الغابة: ج3، ص135، ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص267.
[94] ابن الأثير، أسد الغابة: ج3، ص135.
[95] ابن فندق، لباب الأنساب: ج1، ص365.
[96]يُنظر: ص(50) من الرسالة.
[97] ابن الأثير، أسد الغابة: ج5، ص469.
[98]أبو النصر، عمر، فاطمة بنت محمد، ط ـ القاهرة، 1947: ص70.
[99]حسن، علي إبراهيم، نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب، ط ـ القاهرة، 1963: ج1، ص49.
[100]المامقاني، عبد الله، تنقيح المقال، ط ـ النجف الأشرف، 1352هـ: ص79.
[101]القزويني، زينب: ص 54.
[102]بنت الشاطئ، بطلة كربلاء: ص32 ـ 33.
[103]النقدي، زينب الكبرى: ص35؛ علي، موسى محمد، عقيلة الطهر والكرم السيدة زينب (رضي الله عنها)، ط ـ مصر، بلا. ت: ص72.
[104]النقدي، زينب الكبرى: ص35؛ علي، عقيلة الطهر: ص72.
[105] عمر بن رضا كحالة، أعلام النساء: ص91؛ النقدي، زينب الكبرى: ص36.
(*) محمد بن عمر: بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله، عدّه البرقي من أصحاب السجاد× روى عن جده علي بن أبي طالب×، وإذا ما صح مقتله سنة خمس وأربعين ومائه فهو من أصحاب الصادق× ايضاً، الخوئي، أبو القاسم الموسوي، معجم رجال الحديث النجف، 1978: ج7، ص74.
(**)عطاء بن السائب: ذكره الشيخ الصدوق، روى عن الإمام السجاد×، وذكره أغلب أئمة الحديث بأنه كان ثقة في حديثه القديم، ولكنه اختلط وتغير، والسبب في هذا الطعن فيه أنه تحوَّل إلى مذهب الأمامية الاثني عشرية في مرحلة متقدمة من حياته، الخوئي، المعجم: ج11، ص 155ـ 156.
(***)فاطمة بنت الحسين بن علي بن ابي طالب وأمُّها أمَُ اسحاق بنت طلحة بن عبيد الله تزوجها ابن عمِّها الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، فولدت له عبد الله وابراهيم والحسن وزينب، ثم مات عنها، فتزوجها عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان، فولدت له القاسم ومحمد الملقب بـ(الديباج)، وقد نقل عدة أحاديث عن فاطمة بنت الحسين، بن سعد، الطبقات: ج6، ص319ـ320.
[106]غلامي، حسين غيب، احراق بيت فاطمة، ط ـ 2 بيروت، 2000: ص68.
[107]الاصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص60.
[108] ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد (ت 241 هـ)، الورع، ط ـ مصر، 1340هـ: ص 39.
[109]الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن (ت 460 هـ) الغيبة، ط ـ قم، بلا. ت: ص138؛ الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ت 381 هـ)، كمال الدين وتمام النعمة ط ـ 2 طهران، 1395هـ: ج2، ص 501.
[110] موسى محمد علي، عقيلة الطهر والكرم: ص73.
(*) أمُّ أيمن: كانت مولاة النبي | وحاضنته، اسمها بركة وكان رسول الله | ورثها من أبيه واعتقها حين تزوج بخديجة بنت خويلد، فتزوَّجها عبيد بن زيد بن حارثة بن الخزرج أمَّ أيمن فولدت له أيمن، صحب النبي وقتل يوم حنين شهيداً، للمزيد يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج6، ص167ـ 168.
[111] ابن قولويه، أبو القاسم جعفر بن محمد (ت 367 هـ)، كامل الزيارات، صحَّحه وعلَّق عليه: عبد الحسين الأميني التبريزي، ط ـ النجف الأشرف، 1356: ص360ـ 366.
(1) ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد (ت 275 هـ)، تأريخ الخلفاء، تحقيق محمد فصيح الحافظ، ط ـ 2 بيروت، 1986: ص 25؛ ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 276 هـ)، الإمامة والسياسة، علَّق عليه ووضع حواشيه: خليل المنصور، ط1 بيروت، 2001: ج1، ص131؛ ابن عبد ربه، أبو عمر احمد بن محمد الاندلسي (ت 328 هـ)، العقد الفريد، شرحه وضبطه وصححه احمد أمين وآخرون ط ـ 2 مصر، 1962: ج4، ص361؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص194؛ حسن، علي إبراهيم، التأريخ الإسلامي العام، ط6 القاهرة، 2005: ص 268.
(*) هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، وكنيته أبو عبد الرحمن، وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، ولي حكم الدولة الإسلامية تسع عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة وعشرين يوما، ابن عبد ربه، العقد الفريد: ج4، ص362 .
[113] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص141؛ الشبلنجي، نور البصار: ص 12؛ العلوي، هادي، الاغتيال السياسي في الإسلام، ط ـ بيروت، 1987: ص 73ـ74.
[114] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص142.
[115] ابن عبد ربه، العقد الفريد: ج4، ص368.
([116]] الدينوري، أبو حنيفة احمد بن داود (ت 282 هـ)، الأخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، ط ـ 2 قم، 1977: ص 225ـ226؛ الطيباوي، عبد اللطيف، محاضرات في تأريخ العرب والإسلام، ط ـ بيروت، 1963: ج1، ص147؛ يعقوب، أحمد حسين، النظام السياسي في الإسلام، ط ـ لندن، 1992: ص 182.
[117] ابن عبد ربه، العقد الفريد: ج4، ص373؛ منصور، الشقيقان: ص 38.
[118]الدينوري، الأخبار: ص 226 ؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص259 ؛ سبهر، لسان الملك ميرزا محمد تقي، ناسخ التواريخ في أحوال حضرة سيد الشهداء×، عني بمراجعة أصوله: نخبة من العلماء، ط ـ 4 طهران، 2000: ج1، ص364 (باللغة الفارسية)؛ عبد الآخر، أبو الوفا أحمد، التآمر على التأريخ الإسلامي، ط ـ القاهرة، 1990: ص 140.
([119]] ابن عبد ربه، العقد الفريد: ج4، ص373.
[120]الدينوري، الأخبارالطوال: ص 226؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص259؛ أبو السعود، صلاح، الشيعة النشأة السياسية والعقيدة الدينية، ط ـ 2 القاهرة، 2004: ص 67.
[121]الدينوري، الأخبارالطوال: ص 226؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد: ج4، ص373؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص259؛ المختار، عبد الهادي، لماذا قتل الحسين×، بحث منشور في مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 9 و10، السنة الثامنة، 1947: ص19.
[122]الدينوري، الأخبارالطوال: ص 226؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص259.
[123] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص259؛ سبهر، ناسخ التواريخ: ج1، ص364 .
[124] ابن ماجة، تاريخ الخلفاء: ص 27؛ الدينوري، الأخبارالطوال: ص 225؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد: ج4، ص362؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص259، زعرور، إبراهيم وعلي أحمد تاريخ العصر الأموي السياسي والحضاري، ط ـ دمشق، 2004: ص 31؛ أبو النصر، عمر، الحسين بن علي حفيد محمد بن عبد الله، ط بيروت، 1934: ص34.
[125]ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (تاريخ 276 هـ)، عيون الأخبار، ط ـ مصر، 1963: ج2، ص239.
[126] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص263؛ سبهر، ناسخ التواريخ: ج1، ص380 ؛ حسن، إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ط ـ 8 مصر، 1996: ج1، ص234 .
[127] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص168؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص263، وقد زاد ابن الأثير عليهما عبد الله بن عمر؛ ابن اعثم، أبو محمد احمد الكوفي (ت 314 هـ)، كتاب الفتوح، تحقيق: علي شيري، ط ـ بيروت، 1991: ج5، ص10؛ سبهر، ناسخ التواريخ: ج1، ص381؛ الحوفي، أحمد محمد، أدب السياسة في العصر الأموي، ط ـ بيروت، 1965: ص40.
(*) هو مروان بن الحكم بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وُلِّي حكم الدولة الإسلامية لتسعة أشهر وثمانية عشر يوما، مات سنة 65 هـ وله ثلاث وستون سنة؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد: ج4، ص398؛ وكان لايُولَد لأحد مولود إلا أُتِي به إلى النبي | فيدعو له، فلما وُلد مروان أُدخل عليه، فقال | : (هو الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون)؛ الدميري، كمال الدين محمد بن موسى (ت 682 هـ) حياة الحيوان الكبرى، عنى بتصحيحه عبد اللطيف سامر، ط ـ 1 قم، 2004: ج2، ص215.
[128] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص264؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص 247.
[129] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص264، العلايلي، عبد الله، الإمام الحسين،أيام الحسين عرض وقصص، ط ـ بيروت، بلا. ت، حلقة 3،ص554، حسن، تاريخ: ج1، ص234.
[130] اليعقوبي، تاريخ: ج2، ص168 .
[131] ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر الحسيني (ت 664 هـ)، اللهوف على قتل الطفوف، ط ـ قم، 1981: ص 40؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص14.
[132]الطبري، محمد بن جرير (ت 310 هـ)، استشهاد الحسين، تحقيق السيد الجميلي، ط ـ 2 بيروت، 1997: ص 33؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص365.
[133] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص20؛ بحر العلوم، محمد تقي، مقتل الحسين، ط ـ بغداد، 1978: ص 170؛ شمس الدين، محمد مهدي، ثورة الحسين ظروفها الاجتماعية و آثارها الإنسانية، ط ـ 6 بيروت، 1981: ص 131.
[134] ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 275 هـ)، سنن ابن ماجة، ط ـ بيروت، 2000: ص 532.
[135]الإمام مالك، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك (ت 179 هـ)، الموطأ، رواية يحيى بن يحيى المصمودي، تقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي، ط ـ بيروت، 1997: ص 546.
[136] القصص، آية21.
(*) أمُّ سلمة: وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، زوَّجها إلى النبي | ابنها سلمة، وكانت قبل الرسول | عند عبد الله بن عبد الأسد، ابن هشام، السيرة: ج4، ص215؛ ابن سعد، الطبقات: ج6، ص64.
(**)أمُّ هانئ، وهي فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب وأُمُّها فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أخت الإمام علي× من أمه وأبيه، وإحدى الملازمات له طوال حياته، ابن سعد، الطبقات: ج6، ص34؛ الخوارزمي، المناقب: ص 46.
(***)أُمُّ البنين هي فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية، وسُمِّيت بأمِّ البنين لإنجابها أربعة،أبناء هم العباس، وجعفر، وعبد الله، وعثمان قُتِلوا كلُّهم مع الحسين بالطف، ابن الأثير، الكامل: ج3، ص199؛ الشافعي، مطالب السؤول: ج1، ص263.
[137] ابن اعثم، الفتوح: ج5، ص21.
[138] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص303؛ الشرواني، حيدر علي بن محمد (من أعلام القرن الثاني عشر الهجري)، مناقب أهل البيت، تحقيق محمد الحسون، قم، 1994: ص 426؛ منصور، الشقيقان: ص 24.
[139]الطبراني، الحافظ سليمان بن أحمد (ت 360 هـ)، المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، ط ـ 2 مصر، بلا. ت: ج3، ص110؛ الخطيب البغدادي، ابو بكر احمد بن علي (ت 463 هـ)، تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ط ـ مكة المكرمة، بلا. ت: ج1، ص142.
[140]البيهقي، أبو بكر احمد بن الحسين (ت458 هـ)، دلائل النبوة وأحوال صاحب الشريعة، وثّق أصوله عبد المعطي قلعجي، ط ـ بيروت، 1985: ج6، ص468.
[141]الطبري، عماد الدين أبو جعفر محمد بن أبي القاسم (كان حيا حتى عام 553 هـ)، بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، تحقيق جواد القيومي، ط ـ 2 قم، 2002: ص 308.
[142]ابو نعيم الاصفهاني، أحمد بن عبد الله (ت 430 هـ)، دلائل النبوة، ط ـ 2 بيروت، 1985: ج2، ص554؛ القرطبي، شمس الدين أبو عبد الله الأنصاري (ت 671 هـ)، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ط ـ بيروت، 1986: ج2، ص644؛ ابن نما، جعفر بن محمد بن جعفر الحلي (من أعلام القرن السابع الهجري) ذوب النضار في شرح الثار، ط ـ قم، 1996: ص 14.
[143]مغنية، الحسين وبطلة كربلاء: ص 202 .
[144]اليعقوبي، تأريخ اليعقوبي: ج2، ص169؛ ابن طاووس، اللهوف: ص 54؛ أبو السعود، الشيعة: ص 69.
(*)هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب، وأمُّه أمُّ ولد يقال لها علية، كان أبوه عقيل قد اشتراها من الشام، الاصفهاني: ص 52؛ السماوي، محمد طاهر، إبصار العين في أنصار الحسين، تحقيق محمد جعفر الطبسي، ط ـ قم، 1998: ص 78؛ وله من الأولاد الطاهر والمطهر قُتِلا بعد واقعة الطف بقليل؛ البحراني، حسين بن محمد بن أحمد بن عصفور، كتاب الوفيات، ط ـ بيروت، بلا. ت: ص 228ـ229.
[145]اليعقوبي، تأريخ: ج2، ص169؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص65؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص267؛ المالكي الفصول المهمة: ص 169؛ عليان، الشيعة: ص 190ـ191.
[146]الحسني، هاشم معروف، الانتفاضات الشيعية في التأريخ، ط ـ 2 قم، 1983: ص 436ـ 438.
[147] ابن اعثم، الفتوح: ج5، ص23.
[148]البلاذري، أبو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279 هـ)، أنساب الأشراف، تحقيق محمد باقر المحمودي، ط ـ 1 بيروت، 1977: ج3، ص162؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص 244؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص66؛ الوردي، علي، حركة الحسين ومراميها، بحث منشور في مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 9 و11، السنة الخامسة، 1944: ص 798.
[149] ابن طاووس، اللهوف: ص 84؛ سبهر، محمد تقي، ناسخ التواريخ: ج1، ص123؛ الطبسي، نجم الدين، الإمام الحسين في مكة المكرمة، ط قم، 2001: ج2، ص103.
[150] ابن طاووس، اللهوف: ص 80 ؛ الطبسي، الإمام الحسين: ج2، ص76ـ77؛ رباني، حاج شيخ علي، حسين بن علي×، ط ـ 6 قم، 2000: ص 305، (باللغة الفارسية)؛ البصير، محمد مهدي، الثبات في المبدأ، بحث منشور في مجلة البطحاء، الناصرية، العدد 14، السنة الأولى، 1946: ص 272.
[151] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص277؛ خفاجي، محمد عبد المنعم، من الذكرى الخالدة، بحث منشور في مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 2، السنة الخامسة عشرة، 1953: ص 28.
[152]البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص 163ـ164.
[153] البقرة، آية127.
[154] الحج، آية25.
[155]البخاري، صحيح البخاري: ص 284؛ النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 203 هـ)، سنن النسائي، ط ـ بيروت، بلا. ت: ص 484.
[156]الترمذي، سنن الترمذي: ص 239 .
[157] ابن ماجة، سنن: ص 525 .
[158] ابن الأثير، الكامل: ج5، ص69 .
[159] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص69 .
[160] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص69؛ عبد العليم، محمد محمود، سيدنا الإمام الحسين رضي الله عنه، ط ـ القاهرة، 1977: ص 81.
[161] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص163؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص 244 .
[162] اليعقوبي، تاريخ: ج2، ص244.
[163] المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص70ـ71؛ بحر العلوم، المقتل: ص 318.
(*)القطقطانة: موضع قرب الكوفة من جهة البريد، بينها وبين الرهيمة نيف وعشرون ميلا إذا خرجت من القادسية تريد الشام، ياقوت، شهاب الدين بن عبد الله الحموي (ت 626 هـ) معجم البلدان، ط بيروت، 1977: ج4، ص374 .
(**) الخزيمية: منزل منسوب إلى خزيمة بن خازم، وهي من منازل الثعلبية من الكوفة بينها وبين الثعلبية اثنان وثلاثون ميلاً، ياقوت، المعجم: ج2، ص370 .
[164] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص70 .
[165]الدينوري، الأخبار الطوال: ص 248.
[166]الدينوري، الأخبار الطوال: ص 248.
[167] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص169.
(***)القادسية: بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً، وهو الموضع الذي جرت فيه معركة القادسية سنة 16هـ بين المسلمين والفرس، ياقوت، المعجم: ج4، ص291؛ ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع: ج3، ص1054، وُسمِّيت بالقادسية لأنَّ قوما من أهل قادس من أهل هراة قدموا على كسرى فأنزلهم هذا الموضع وسُمِّي بالقادسية، أبو عبيد، عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت 487 هـ)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق مصطفى السقا، ط ـ 3، القاهرة، 1996: ج3، ص1042.
[168] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص76 .
[169] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص170.
[170] ابن الاثير، الكامل: ج3، ص280ـ281؛ ابن طاووس، اللهوف: ص 98.
(*)عُذيب الهجانات: وهو ماء بين القادسية والمغيثة، بينه وبين القادسية أربعة أميال، وكان الخليفة عمر قد كتب لسعد بن أبي وقاص أن ارتحل حتى تنزل عُذيب الهجانات، ياقوت المعجم: ج4، ص92.
(**)كربلاء: بفتح أوله وإسكان ثانيه، موضع بالعراق من ناحية الكوفة، وفي هذا الموضع قُتِل الإمام الحسين× وفي ذلك قال كثير:
فسِبطٌ سبطُ إيمان وبِر
ٍّوسـبطٌ غيَّبتْهُ كربلاء
ابو عبيد، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: ج4، ص1123.
[171] ابن طاووس، اللهوف: ص 100ـ102؛ الحساني، محمد رضا، الحسين بن علي، بحث منشور في مجلة القادسية، النجف الأشرف، العدد 5، السنة الرابعة، 1366هـ: ص 1.
[172] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص176؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص 253؛ شلبي، أحمد، الدولة الأموية، ط ـ القاهرة، 1981: ص 27؛ أبو السعود، الشيعة: ص81.
[173] ابن طاووس، اللهوف: ص102 .
[174]يُنظر: الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص309ـ314 في تفاصيل تلك اللقاءات والمكاتبات.
[175] اليعقوبي، تأريخ: ج2، ص170؛ المفيد، الإرشاد: ج2، ص95ـ96؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص285؛ الطبرسي، أبو على الفضل بن الحسن من (أعلام القرن السادس الهجري)، إعلام الورى بأعلام الهدى، قدَّم له محمد مهدى الخرسان، ط ـ النجف الاشرف، 1970: ص239، الطريحي، فخر الدين (ت1085 هـ)، المنتخب في المراثي والخطب، ط ـ 3 النجف الاشرف، 1949: ص309؛ الحداد، عبد السادة محمد، الملحمة الحسينية، ط ـ 2 بيروت، 2002: ج1، ص34.
[176] وهذا الكلام خلاف ما هو المشهور في مدرسة أهل البيت^ (مؤسسة وارث الأنبياء).
[177] المفيد، الإرشاد: ج2، ص97؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص286؛ ابن كثير، أبو الفدا عماد الدين إسماعيل بن عمر (ت 774 هـ)، البداية والنهاية، ط ـ مصر، بلا. ت: ج8، ص177؛ الطبرسي، إعلام الورى: ص240؛ المازندراني، معالي السبطين: ج1، ص297ـ298؛ عيش، احمد محمد، صوت الحسين، ط ـ مصر، 1963: ص22؛ عبد العليم، سيدنا الإمام: ص 96.
(*)عمر بن سعد بن أبي وقاص، سار في طليعة الجيش الذي بعثة عبيد الله بن زياد لقتال الحسين وكان قائداً لذلك الجيش حتى نهاية المعركة، قتله المختار الثقفي في ثورته؛ المسعودي، التنبيه والأشراف: ص278·
[178] ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص178؛ الشافعي، عبد الله بن محمد بن عامر، الإتحاف بحبِّ الاشراف، ط ـ مصر، بلا· ت: ص15.
(**) زهير بن القين: البجلي، كان مجانباً للعلويين عثماني الهوى، ولما حج سنة 60 في أهله وعاد، وافق الإمام الحسين× في الطريق والتحق بركبه، وأبلى معه بلاء حسناً واستشهد بين يديه، السماوي، محمد بن طاهر (ت1370هـ)، إبصار العين في أنصار الحسين، تحقيق محمد جعفر الطبسي، ط ـ قم، 1998: ص 161.
(***) حبيب بن مظاهر بن رئاب بن الاشتر الاسدي، صحابي رأى الرسول | وكان ممن كاتب الإمام الحسين×، وكان من خيرة أصحابه يوم الطف، واستشهد بين يدي الإمام الحسين×، السماوي، إبصار العين في أنصار الحسين: ص100ـ106؛ عابدين، محمد علي، الدوافع الذاتية لأنصار الحسين، ط ـ 3 قم، 1983: ص215 ·
(*) شمر بن ذي الجوشن: واسم ذي الجوشن شرحبيل بن الاعور بن معاوية الضبابي الكلابي، قال عنه الإمام الحسين× ليلة الطف إنِّي رأيت في المنام كلباً أبقع يلغ في دمائنا فعبَّرتُه بهذا الأبرص الضبابي، وكان شمر أبرص، وقد كان الرئيس في قتل الإمام الحسين×، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 255 هـ)، البرصان والعرجان والعميان والحولان، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط ـ بغداد، 1982: ص119·
(**) مسلم بن عوسجةبن سعد بن ثعلبة الاسدي، وكنيته أبو حجل، كان رجلا شريفاً عابداً متنسكاً، وكان من صحابة رسول الله|، روى عنه الشعبي، بايع مسلم بن عقيل عند مقدمهِ الكوفة واختفى بعد مقتله، وفر بأهله إلى الإمام الحسين×، فوافاه بكربلاء وفداه بنفسه مستشهدا بين يديه، السماوي، إبصار العين: ص107ـ109·
[179] الطبرسي، أعلام الورى: ص240 ·
[180] سيد الأهل، زينب: ص70 ·
(*)قيس بن الأشعث بن قيس الكندي كان أبوه الأشعث من المعادين للإمام علي×، وشارك أخاه محمد بالغدر بمسلم بن عقيل، فيما سمَّت أخته جعدة الأمام الحسن×، وشارك قيس في قتال الإمام الحسين× وكان له دور كبير في واقعة الطف إلى جانب جيش بن زياد، الريشهري، محمد، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتأريخ، ط ـ قم، 2001: ج11، ص322 ؛ وقد سلب قيس قطيفة الإمام الحسين× بعد مقتله ؛ فكان يسمَّى بعد ذلك بقيس قطيفة، الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص346 ·
[181] الطبرسي، أعلام الورى: ص240ـ242؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص178ـ179.
[182] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص316ـ317 ·
[183] ابن طاووس، اللهوف: ص114؛ سيد الأهل، زينب: ص73ـ74 .
[184] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص 284ـ285؛ المازندراني، معالي السبطين: ص331، النقدي، زينب الكبرى: ص94ـ95، القزويني، زينب من المهد: ص170ـ171.
[185] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص170 ·
[186] ابن طاووس، اللهوف: ص126؛ عثمان، حافظ، الإسلام والصراعات الدينية، ط ـ مصر، 1994: ص 154.
[187]المصدر نفسه: ص 126.
[188] ابن طاووس، اللهوف: ص126·
[189] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص293 .
[190] الدولابي، أبو بشير محمد بن احمد الانصاري (ت 310 هـ)، الذرية الطاهرة، تحقيق محمد جواد الجلالي، ط ـ قم، 1986: ص166·
[191] الديباجي، زينب الكبرى: ص127 ·
[192]القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص201.
[193]القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص214·
[194]القزويني، زينب رائدة الجهاد: ص242·
[195] للمزيد ينظر الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص242ـ243 في قضية مقتل العباس؛ الديباجي، زينب الكبرى: ص120؛ القرشي، زينب رائدة الجهاد في الاسلام: ص239؛ بحر العلوم، مقتل الحسين: ص423؛ القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص206.
[196] ابن طاووس، اللهوف: ص142·
[197] ابن طاووس، اللهوف: ص142؛ جلال، محمود جواد، الصراع بين الحق والباطل، بحث منشور في مجلة الميزان، العمارة، العدد 28، 1367 هـ: ص 14.
[198]القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص221ـ222·
[199] ابن طاووس، اللهوف: ص 147.
[200] معالي السبطين: ج2، ص14؛ سيد الأهل، زينب: ص97·
[201]القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص222·
[202] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص245؛ ابن طاووس، اللهوف: ص148ـ150.
[203]القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص227·
[204] الشافعي، مطالب السؤول، 1ـ2، ص 38؛ الفكيكي، توفيق، مكانة النهضة الحسينية في تأريخ القومية العربية، بحث منشور في مجلة الغري، النجف الأشرف، العدد 9ـ10، السنة الثامنة، 1947: ص 12.
[205] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص294·
[206] الطبري، تاريخ الطبري: ص344؛ المفيد، الإرشاد: ص113؛ بن نما، نجم الدين، (ت 645 هـ)، مثير الأحزان، النجف الأشرف، 1369هـ: ص 55 ـ 56؛ الطبرسي، إعلام الورى: ص249؛ الثعالبي، يحيى كاظم، المروءة الحسينية، بحث منشور في مجلة الميزان، العمارة، العدد 28، السنة الرابعة، 1367 هـ: ص 37.
[207] المفيد، الإرشاد: ص116؛ ابن الأثير، الكامل: ص295·
[208] الخوارزمي، مقتل الحسين: ص37·
[209] المفيد، الارشاد: ص116؛ ابن طاووس، اللهوف: ص150·
[210] الطبري، تاريخ الطبري: ص245؛ المفيد، الارشاد: ص116؛ الجنحاني، الحبيب، التحول الاقتصادي والاجتماعي في مجتمع صدر الاسلام، ط ـ بيروت، 1985: ص168؛ عبد العليم، سيدنا الإمام: ص 115.
[211] القرويني، رضي بن نبي، تظلم الزهراء، ط ـ 2 النجف، 1962: ص214ـ215؛ القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص234ـ235·
[212] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص295·
(*) خولي بن يزيد الأصبحي، وهو الذي ضعف وأرعد عندما أراد أن يحتزَّ رأس الإمام الحسين× فاحتزَّه سنان وأعطاه إياه لإيصاله لابن زياد، ولكنه وصل ليلا ووجد باب القصر مغلقا فذهب به إلى بيته، فأبت زوجته النوار الحضرمية أن تبيت معه، وخرجت من داره، قتل المختار خولي في ثورته؛ الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص346ـ348؛ قانصو، محمود، ما بعد كربلاء، ط ـ قم، 2005: ص 23ـ 24.
[213] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص 346 ؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص295؛ الجمل، وحيد عبد الحكيم، سيرة الحسين في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي الأول، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، 1980: ص95 ·
[214] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص453؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص295.
[215] ابن نما، مثير الأحزان: ص57 .
[216] القرويني، تظلم الزهراء: ص217 .
[217] الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي (ت 381هـ)، الامالي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة، ط ـ قم، 1417هـ: ص 228ـ229؛ قانصو، مابعد كربلاء: ص 43.
[218] ابن طاووس، اللهوف: ص158 ·
[219] المفيد، الارشاد: ص117؛ الطبرسي، اعلام الورى بأعلام الهدى: ص249·
[220] مغنية، محمد جواد، الحسين وبطلة كربلاء: ص190ـ191·
[221] ابن طاووس، اللهوف: ص174؛ المقرم، عبد الرزاق، مقتل الحسين، ط ـ 2 النجف الأشرف، 1956: ص365.
[222]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص348؛ الطبري، محمد بن جرير (ت 310 هـ) استشهاد الحسين، تحقيق ودراسة السيد الجميلي، ط ـ 2 بيروت، 1997: ص 146؛ ابن طاووس، اللهوف: ص 159؛ صبيح، محمود السيد، خصوصية وبشرية النبي عند قتلة الحسين، ط ـ القاهرة، 2005: ص 211.
[223]بحر العلوم، محمد، في رحاب السيدة زينب، ط ـ بيروت، 1975: ص 148ـ149؛ المظفر، عبد العالي، الفتح والاستشهاد في ذكرى الحسين×، بحث منشور في مجلة الأضواء، النجف الأشرف، العدد 3، السنة السادسة، 1966: ص 219.
[224] بحر العلوم، محمد، في رحاب السيدة زينب: ص149
[225] ابن قولويه، كامل الزيارات: ص175 ·
[226] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص349؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص 296؛ النصراوي، حسين عبد الأمير، رأس الحسين× من الشهادة إلى الدفن، ط ـ 1 بيروت، 2000: ص 17.
[227] ابن طاووس، اللهوف: ص170؛ الطبرسي، إعلام الورى: ص250 ـ251 .
[228] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص455؛ الخوارزمي، مقتل الحسين: ص39؛ الطبرسي: ص250.
[229] القريشي، زينب رائدة الجهاد: ص 250 .
[230] الطريحي، المنتخب: ص 336ـ337؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص165 .
[231] القند وزي، الحافظ سليمان بن ابراهيم القند وزي الحنفي (1220ـ1294 هـ)، ينابيع المودة، ط 7، حيدرية، نجف، 1965: ص 221.
[232]الطريحي، المنتخب: ص 337.
[233] الطبسي، محمد جعفر، وقائع الطريق من كربلاء إلى الشام، ط ـ قم، 1382 هـ: ج5، ص9 .
[234] الصفار، المرأة العظيمة: ص 178.
[235] ابو سعيدة، حسين، هكذا أنت يا بطلة كربلاء، ط ـ 3 النجف الاشرف، 2003: ص 60ـ61.
(*) إشارة إلى قوله تعالى: (ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) (النحل، آية92)·
[236] الطبرسي، الأحتجاج: ج2، ص196؛ ابن نما، مثير الأحزان: ص 66ـ67؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ص 261ـ262؛ ابن طاووس، اللهوف: ص 174ـ175؛ ابن طيفور، أحمد بن أبي طاهر (380 هـ)، بلاغات النساء، تقديم أحمد الألفي، ط ـ مصر، 1987: ص 23؛ قانصو، ما بعد كربلاء: ص 52ـ53؛ الحداد، الملحمة الحسينية: ج1، ص35؛ الشهرستاني، زينب في عاصمة: ص3.
[237] الطبرسي، الأحتجاج: ج2، ص196؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص 182.
[238] المجلسي، بحار الانوار:ج45، ص 115.
[239] الطبرسي، الإحتجاج: ج1، ص303؛ ابن طاووس، اللهوف: ص 174·
[240]الجمل، سيرة الحسين: ص 99 ·
[241] ينظر ص(102) من الرسالة ·
[242]الطبسي، وقائع الطريق: ج5، ص9 ·
[243] يُنظر: ص(111) من الرسالة·
[244] يُنظر: ص(111) من الرسالة·
[245]المازندراني، معالي السبطين: ص 57 ·
[246] ابن طاووس، اللهوف: ص 184ـ188؛ قانصو، ما بعد كربلاء: ص 53ـ54.
[247] الصفار، المرأة العظيمة: ص 196·
[248] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص351 ·
[249] الدينوري، الأخبار الطوال: ص231؛ المفيد، الارشاد: ج2، ص119؛ ابن لأثير، الكامل: ج3، ص296ـ297؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص116؛ الطريحي، المنتخب: ص338 ·
[250] المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص116؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص191.
[251] الطبري، تاريخ الطبري الرسل والملوك: ج4، ص349؛ المفيد، الارشاد: ج2، ص119ـ120؛ ابن اعثم، الفتوح: ج5، ص222ـ223؛ بن طاووس، اللهوف: ص70؛ الطبرسي، اعلام الورى: ص251ـ252؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص116؛ المازندراني، معالي السبطين: ص574ـ576 ·
[252] الزمر، آية41.
[253] المفيد، الارشاد: ج2، ص120ـ121؛ الطبرسي، إعلام الورى، ص252؛ كحالة، أعلام النساء: ج2، ص93ـ94؛ الأسفرائيني، نور العين: ج1، ص33ـ34؛ المازندرني، معالي السبطين: ص 577، مجلد1.
[254] المفيد، الارشاد: ص122 ·
[255] ابن طاووس، اللهوف: ص194؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص166.
[256] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص351 ·
[257] سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص 270.
[258] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص354 ؛ ابن الاثير، الكامل: ج3، ص298·
[259] ابن الصباغ، الفصول المهمة: ص 204؛ ابن طاووس، اللهوف: ص 202·
[260] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص352·
(*) دمشق: سميت نسبة إلى دماشق بن نمرود بن كنعان ؛ لأنه هو الذي بناها، ولهاتسمية أخرى هي جيرون، ابو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج2، ص556؛ وهي قصبة بلاد الشام وجنتها لحسن عمارتها، وكثرة أشجارها ومياهها، وقيل إنَّها سُمِّيت بذلك لأنهم دمشقوا في بنائها أي أسرعوا، ابن عبد الحق البغدادي، مراصد الاطلاع: ج2، ص534
(1) ابن طاووس، اللهوف: ص 206.
(2) المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص 127ـ 128؛ قانصو، ما بعد كربلاء: ص 28.
(**) باب توما: أحد أبواب مدينة دمشق ويسمى أيضا باب توماء، وهي الباب التي دخل منها يزيد بن أبي سفيان عند حصار دمشق على عهد الخليفة أبي بكر، ياقوت، المعجم: ج1، ص 307؛ ابن عبد الحق البغدادي، مراصد الاطلاع: ج1، ص143·
[261] المقدسي، البدء والتأريخ: ج5، ص12؛ ابن اعثم، أبو محمد أحمد الكوفي (ت 314 هـ)، مقتل الحسين وثورة المختار، ط ـ 2 إيران، 2004: ص 167ـ168·
[262] الشورى، آية23·
(1) الاسراء، آية26·
[263] الاحزاب، آية33.
[264] ابن اعثم، الفتوح: ج5، ص242ـ243·
[265] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص352 ·
[266] الدينوري، حياة الحيوان: ص53 ·
[267] الطبري، تاريخ الطبري: ص 459؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص270؛ ابن أعثم، الفتوح: ص 236؛ المالكي، الفصول المهمة: ص204·
[268] الطبري، تاريخ الطبري: ص 352؛ الديار بكري، تأريخ الخميس: ج2، ص299·
[269] ابن سعد، الطبقات الكبرى، ترجمة الأمام الحسين ومقتله من القسم غير مطبوع، تحقيق: عبد العزيز الطباطبائي، القاهرة، بلا· ت: ص 82 ·
[270] الاميني، مع الركب الحسيني: ص 102 ·
[271] ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص192؛ المجلسي، البحار: ص 133؛ المالكي، الفصول: ص 205.
[272] المفيد، الإرشاد: ج2، ص124؛ الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص352·
[273] سبهر، تأريخ: ج3، ص133·
[274] ابن طاووس، اللهوف: ص 210؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص272؛ زيادة، محمد مصطفى، الحسين في التأريخ، بحث منشور في مجلة البيان، النجف الأشرف، العدد 11ـ14، السنة الأولى، 1947: ص 287.
[275] ابن طاووس، اللهوف: ص 210·
[276] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص299 ·
[277] القندوزي، ينابيع المودة: ج3، ص92·
[278] الاميني، مع الركب الحسيني: ص 154 ·
[279] ابن طاووس، اللهوف: ص 212؛ الطبرسي، الأحتجاج: ج2، ص199.
[280] المفيد، الارشاد: ج2، ص124؛الخوارزمي، مقتل الحسين: ج2، ص62؛ الطبرسي، إعلام الورى: ص 253؛ الطبرسي، الأحتجاج: ج2، ص200؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص 274؛ عبد الحميد: صائب، تأريخ الإسلام الثقافي والسياسي: ص 672.
[281] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص353؛ الصدوق، الامالي: ص 231؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص299 ·
[282] الزمر، آية42.
[283] الشورى، آية30.
[284] الحديد، آية22 و23.
[285]الاصفهاني، مقاتل الطالبين: ص80 ·
[286] الأميني، الركب الحسيني: ج6، ص172 ·
[287] اليعقوبي، تأريخ: ج2، ص171؛ ابن اعثم، مقتل الحسين: ص165ـ166.
[288] ابن ماجة، سنن ابن ماجة: ص 34·
[289] ابن الاثير، الكامل: ج3، ص299؛ ابن اعثم، مقتل الحسين، 166ـ167؛ ابن طاووس، اللهوف: ص212؛ آل ياسين، عز الدين، بحث منشور في مجلة الغري، العدد 9ـ11، السنة الخامسة، 1944: ص 826.
[291] الروم، آية10 ·
[292] ابن طاووس، اللهوف: ص 214ـ220؛ الخوارزمي، مقتل الحسين: ج2، ص64ـ66؛ الطبرسي، الأحتجاج: ج2، ص199ـ200؛ الصفار، حسن موسى، المرأة العظيمة: ص201ـ203؛ الحداد، الملحمة الحسينية: ج1، ص35.
[293] آل عمران، الآية، 187·
[294] آل عمران، الآية، 169·
[295] الكهف، آية50 ·
[296] مريم، آية75·
[297] الحج، آية10 ·
[298] ابن طاووس، اللهوف: ص 220·
[299] يُنظر: ص(135) من الرسالة.
[300] يُنظر: ص(135) من الرسالة .
[301] يُنظر: ص(134) من الرسالة .
[302] يُنظر: ص(135) من الرسالة .
[303] يُنظر: ص(135ـ 136) من الرسالة .
[304] يُنظر: ص(135) من الرسالة·
[305] بحر العلوم، في رحاب: ص 184·
[306] الشهرستاني، هبة الدين، نهضة الحسين، ط ـ النجف الأشرف، 1978: ج1، ص137 ·
[307] السيوطي، تأريخ الخلفاء: ص207؛ بحر العلوم، في رحاب: ص184ـ185.
[308]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص356·
[309] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص299 ·
[310] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص299ـ300؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص271
[311] القريشي، زينب: ص275؛ الأميني، الركب الحسيني: ج6، ص167 ·
[312] الصفار، المرأة العظيمة: ص 208 ·
[313] ابن اعثم، مقتل الحسين: ص 171 ·
[314] يُنظر: ابن اعثم، مقتل الحسين: ص172، في تمام خطبة الإمام السجاد×
[315] يُنظر: المصدر نفسه: ص 172، في تمام خطبة الإمام السجاد× ·
[316] ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص198 ·
[317] الطبرسي، الإحتجاج: ج2، ص20؛ ابن طاووس، اللهوف: ص 230؛ الأصفهاني، الأغاني: ص 80ـ81 ·
[318] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص160؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد: ج5، ص130؛ ابن عساكر، ترجمة الإمام الحسين: ص 208؛ ابن العديم، بغية الطالب: ج6، ص261 ·
[319] الشبلنجي، نور الأبصار: ص 129ـ130؛ محمد، سعد حسن، أهل البيت في مصر، ط ـ مصر، 2003: ص 69ـ70.
[320] سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص 286 ·
[321] الأميني، الركب الحسيني: ج6، ص63 ·
[322]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص353 ؛ الشبلنجي، نور الأبصار: ص 132 ·
[323] الصدوق، الأمالي: ص 231؛ ابن طاووس، اللهوف: ص 222 ·
[324] المفيد، الارشاد: ج2، ص126 ·
[325]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص355 ·
[326] المالكي، الفصول المهمة: ص 206 ·
[327]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص356؛ ابن الاثير، الكامل: ج3، ص298 ·
[328] الطبقات الكبرى، القسم غير المطبوع: ص 83 ·
[329] الخوارزمي، مقتل الحسين: ص 74 ·
[330] الطبقات الكبرى، القسم غير المطبوع: ص 83 ؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص 271؛ الخوارزمي، مقتل الحسين: ص 74 ·
[331]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص353؛الخوارزمي، مقتل الحسين: ص 74؛ ابن الاثير، الكامل: ج3، ص299؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص195 ·
[332]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص355 ·
[333] ابن الأثير، الكامل: ج3، ص299؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص196·
[334] الاميني، الركب الحسيني: ج6، ص233 ·
[335] ابن طاووس، اللهوف: ص 212·
[336] الخوارزمي، مقتل الحسين: ص 74 ·
[337]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص353ـ354؛ المفيد، الارشاد: ج2، ص126؛ الخوارزمي، مقتل الحسين: ص 74؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص300.
[338] الأميني، الركب الحسيني: ج6، ص268 ·
[339] الطبقات الكبرى، القسم غير المطبوع: ص 84؛ ابن عساكر، ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت571 هـ)، ترجمة الإمام زين العابدين علي بن الحسين× من تأريخ دمشق، تحقيق محمد باقر المحمودي، ط ـ طهران، 1993: ص 21 ·
[340] الطبقات الكبرى، القسم غير المطبوع: ص 84 ·
[341] المفيد، الارشاد: ج2، ص127؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص300·
[342]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص354؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص300؛ الخوارزمي، مقتل الحسين: ص 75؛ ملاحظة (لعل المقصود بهذا الرجل الشامي هو محرز بن حريث الكلبي حيث قال عنه ابن سعد في القسم الغير مطبوع ص 84 هو من أفاضل أهل الشام)·
[343] ابن طاووس، اللهوف: ص 232 · (يراجع المتهدج للطوسي) ·
[344] الواثقي، حسين، جابر بن عبد الله الانصاري حياتهُ ومُسنده، ط ـ إيران، 1378 هـ: ص 77 .
[345]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص356؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص300؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص197·
[346]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص356، المفيد، الإرشاد: ج2، ص127.
[347]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص356؛ المفيد، الإرشاد: ص 127·
[348]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص357؛ المفيد، الإرشاد: ص 128؛ ابن الأثير، الكامل: ج3، ص300؛ عبد الرزاق، مقتل الحسين: ص 405 ·
[349]يُنظر: ص(77) من الرسالة.
[350] اليعقوبي، تأريخ اليعقوبي: ج2، ص171 ·
[351]الطبراني، المعجم الكبير: ج3، ص114؛ الطبري، ذخائر العقبى: ص 146.
[352] المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص147 ؛ الطريحي، المنتخب: ص 355ـ356.
[353] الطريحي، المصدر نفسه: ص 358·
[354]الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص357 ·
[355] الصفار، المرأة العظيمة: ص 238·
[356] النقدي، زينب: ص 122؛ بنت الشاطئ، السيدة زينب: ص 155؛ مغنية، مع بطلة كربلاء: ص 90·
[357] العبيدلي، أخبار الزينبات: ص 118ـ121؛ محمد، أهل البيت في مصر: ص 102.
[358] العبيدلي، المصدر نفسه: ص 122·
[359] الصفار، المرأة العظيمة: ص 245·
[360] شلبي، علي أحمد، ابنة الزهراء زينب، ط ـ مصر، بلا.ت: ص 265؛ النقدي، زينب الكبرى: ص 117؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص 246·
[361] النقدي، زينب الكبرى: ص116ـ117؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص 245ـ246؛ شلبي، ابنة الزهراء زينب: ص 265ـ267؛ القرشي، السيدة زينب: ص 292 ·
[362] القرشي، السيدة زينب: ص 293؛ النقدي، زينب الكبرى: ص 117·
[363] الشلبي، ابنة الزهراء: ص 270ـ273؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص 247ـ248·
[364] القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص 593ـ594؛ النقدي، زينب الكبرى: ص 115·
[365] المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد (ت 845 هـ)، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ط ـ مصر، 1324: ص 285ـ288·
[366] المقريزي، تقي الدين، المواعظ والأخبار بذكر الخطط والآثار: ص 285ـ288·
[367] يُنظر: ابن تغري بردى، جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 874 هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ط ـ مصر، 1963: ج1، ص156ـ 171.
[368] مرقد العقيلة زينب، في ميزان الدراسة والتحقيق، تحقيق: صفدر عباس السابقي، ط ـ 2، بيروت، 2001: ص 29ـ30·
[369] السابقي، مرقد العقيلة، المصد السابق: ص 32ـ33·
[370] ابن جبير، أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني (ت 614 هـ)، رحلة ابن جبير تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار، ط ـ مصر، بلا. ت: ص 49.
[371]المصدر نفسه: ص 49.
[372]المصدر نفسه: ص 49.
[373] ابن بطوطة، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة (ت 770 هـ)، رحلة بن بطوطة، مصر، الازهرية، 1928: ص 21·
[374] ياقوت، معجم البلدان: ص 54·
[375] السابقي، مرقد العقيلة: ص 35·
[376] القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص 116ـ117·
[377] الصفار، المرأة العظيمة: ص 255·
[378] يُنظر: ابن طباطبا، ابو المعمر يحيى بن محمد بن القاسم الحسني (ت 478 هـ)، أبناء الإمام في مصر والشام، تحقيق محمد نصار ابراهيم، ط ـ القدس، 1934، ففي الكتاب أسماء كل من دفن من ابناء الإمام في المكانين·
(*) الفاطميون: أسَّسوا دولتهم في المغرب وشمال أفريقيا للفترة (296هــ576 هـ)، بزعامة أبي محمد عبيد الله بن محمد المهدي، واتخذوا التشيُّع مذهباً لهم، الموسوي، عبد الرسول، الشيعة في التأريخ، ط ـ 2، القاهرة: ص322.
[379] الهاشمي، علي بن الحسين، عقيلة بني هاشم، ط ـ النجف الأشرف، 1967: ص 48.
(*)راوية: قرية من غوطة دمشق بها قبر أمِّ كلثوم،وقبر مدرك بن زياد الفزاري؛ ياقوت: ج3، ص20.
[380] القزويني، زينب من المهد إلى اللحد: ص 601؛ القرشي، رائدة الجهاد: ص 209؛ القطيفي، وفاة زينب الكبرى: ص 212؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص 241·
[381] السابقي، مرقد العقيلة: ص 91؛ وزارة الإعلام السورية، البيان العام للهبات والنفقات لبناء وتعمير مقام السيدة زينب، ط دمشق، 1968: ص 4 ·
[382] ابن جبير، الرحلة: ص 196.
[383] ابن بطوطة، رحلة بن بطوطة: ص 60·
[384] ابن عسكر، أبو العباس علي بن الحسين، التأريخ الكبير، ط ـ دمشق، 1329، مجلد 1، ص224·
[385]ياقوت، معجم البلدان: ج3، ص (20-21).
[386] العاملي، أعيان الشيعة: ص 136·
[387] العاملي، أعيان الشيعة: ص 136·
[388] السابقي، مرقد العقيلة، المصد السابق: ص 141·
[389] الصفار، المرأة العظيمة: ص 243؛ السابقي، مرقد العقيلة، المصد السابق: ص 145·
[390] الصفار، المرأة العظيمة: ص 244؛ السابقي، مرقد العقيلة، المصد السابق: ص 231·
[391]يُنظر: ص(161) من الرسالة .
[392]يُنظر: ص(162) من الرسالة .
[393]يُنظر: ص(162) من الرسالة .
[394] يُنظر: أبناء الإمام في مصر والشام.
(*) سنجار: وهي برية الثرثار، ومدينتها الحضر، أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج3، ص760، وهي مدينة مشهورة، بينها وبين الموصل ثلاثة أيام، ابن عبد الحق البغدادي، مراصد الإطلاع: ج2، ص743·
(**) البويهيون: أسَّسوا دولتهم في بلاد فارس وحكموا معها العراق للفترة (312ـ447هـ) ومؤسس هذه الدولة علي بن بويه، وتعتبر دولتهم من دول الشيعة في التأريخ، الموسوي، الشيعة: ص 323·
(***) الحمدانيون: أسَّسوا دولتهم في سوريا وشمال العراق للفترة (281ـ392هـ) ومؤسِّس هذه الدولة التي اعتنق حكامها مذهب التشيع هو حمدان بن حمدون، الموسوي، الشيعة: ص 322·
(****) العقيليون: أسَّسوا دولتهم للفترة (380ـ499هـ) بزعامة محمد بن مسيب بن رافع العقيلي، وأتخذ رجالات دولتهم التشيع مذهباً لهم، الموسوي، الشيعة: ص 322·
[395] شمسياني، حسن كامل، مرقد السيدة زينب في سنجار (شمال العراق)، بحث منشور في مجلة الموسم، لندن، المجلد الأول، العدد الرابع، 1989: ص 924؛ الصفار، المرأة العظيمة: ص 249·
[396] يُنظر: ص(160) من الرسالة ·
[397] الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص357·
[398] انظر السابقي، مرقد العقيلة: ص 89 ·
[399] العاملي، أعيان الشيعة: ج3، ص207 ·
(*)يُنظر: اليعقوبي، تأريخ: ج2، ص174ـ175؛ الطبري، تاريخ الطبري: ج4، ص370ـ381، لمعرفة التفاصيل الكاملة لواقعة الحرة·
[400] القريشي، السيدة زينب: ص 289·