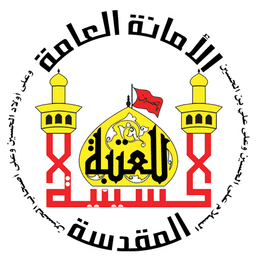ﭐ(وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ * وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ).
صدق الله العلي العظيم
(البقرة: آية154ـ 157).
اللهمّ لجلال قدرك وعظمة شأنك وعزّتك أضع عملي بين يدَي رحمتك، اللهمّ فاغفر لي خطيئتي وذنبي في الدنيا والآخرة.
إلى/المبعوث رحمة للعالمين إمام المتّقين وسيّد المُرسلين وشفيعنا يوم الدين... «محمّد الصادق الأمين’ »...
إلى/وسيلتي إلى الله وشفيعتي يوم المعاد أمّ الأئمّة الأطهار الصدِّيقة الطاهرة... «فاطمة الزهراء‘»...
الى/مَن اصطفوا من قِبَل الله فصاروا أصفياءه.
إلى/مَن عَرفوا أنّ الحبّ لا يكون إلّا لله فصاروا أحبّاءه.
إلى/مَن لا يعطون حقّ الودّ إلّا لله فصاروا أودّاءه.
إلى/مَن هاموا وجُنّوا في حبّ الحسين×.
إلى/مَن تركوا الأهل والأحبّة فداء للحسين×.
إلى/مَن استأنســوا بالمنيّــة دون الحسين×.
إلى/مَن أحال سنوات عمره قناديل تُضيء طريقي … «والدي»... رحمة ونوراً مهداة إلى روحك الطاهرة.
إلى/مَن واصلت ليلها ونهارها بالدعاء لي، بحر الحنان وعنوان الصبر وينبوع المحبّة … «والدتي» … وفاءً ودعائي لها بالشفاء.
إلى/إخوتي وأخواتي … الأعزّاء.
إلى/رفيقة دربي التي كابدت معي كلّ الصعاب... «زوجتي»...
إلى/فلذات كبدي... «أولادي»...
* * أُقدِّم بحثي هذا لكلّ هؤلاء* *
الباحث
الرمز |
الشرح |
|
د. ت |
لا توجد سنة الطبع |
|
د. ط |
لا يوجد إسم المطبعة |
|
د. م |
لا يوجد إسم مدينة الطبع |
|
ت |
تُوفّي |
|
ج |
الجزء |
|
د. |
الدكتور |
|
ص |
الصفحة |
|
ط |
الطبعة |
|
ع |
العدد |
|
ق |
القسم |
|
م |
السنة الميلادية |
|
مج |
المجلّد |
|
هــ |
السنة الهجرية |
|
p. |
الصفحة |
|
« » |
نصّ مقتبس |
|
( ) |
اقتباس الآيات القرآنية |
|
كم |
المسافة بالكيلو متر |
الشكرُ للهِ سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما سخّر لي من أسبابه، وأسهب لي من إحسانه وفضله، وأمكنني من إكمال رسالتي.
لا بدّ لي بعد أن أنجزت إعداد هذه الرسالة، أن أتقدّم بجزيل الشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور نزار عبد المحسن؛ لما بذله من جهد علمي ومتابعة وحرص شديدين وما قدّمه لي من عون ومساعدة، كما أهدي شكري وتقديري إلى أساتذة قسم التاريخ، وبالأخص الأساتذة الذين قاموا بتدريسي خلال المراحل الدراسية السابقة، ولكل مَن قدّم إليّ التوجيه والإرشاد في كتابة البحث، وبالأخص إلى الدكتور جواد، والدكتورة إنتصار؛ لما قدّماه لي من توجيه وإرشاد.
وشكر موصول إلى الدكتورة رباب جبّار السوداني؛ التي لم تبخل عليّ بوقتها وجهدها، فلها منّي جزيل الشكر والامتنان، وعرفاناً بالجميل أسدي عميق شكري إلى الأستاذ الدكتور ستّار جبّار علوان؛ لما قدّمه لي من إرشادات وتوجيهات قوّمت مسار البحث، كما لا أنسى المساعدة القيّمة التي قدّمها لي الدكتور توفيق الحجّاج، الذي كانت مكتبته العامرة مفتوحة أمامنا، وأمام كلّ طالب علم فله خير الدعاء.
والشكر موصول إلى جميع أساتذتي في السنة التحضيرية، الذين قدّموا لي التوجيه والمعلومات القيّمة، خاصّة في ما يتعلّق بكتابة البحث، ولما قدّموه من معلومات قيّمة فلهم منّي كلّ الشكر والتقدير.
وفي الختام أسجّل شكري وتقديري لكلّ مَن قدّم لي مساعدة مهما كانت، وأخصّ بالذكر منتسبي مكتبة الجامعة المركزية ومكتبة الآداب ومكتبة قسم التاريخ، وكلّ مّن مدّ لي يد العون، وجزى الله الجميع خير الجزاء.
إلى اليد التي خطّ يراعها كلمات الرسالة، إلى عينيّ اللتينِ أبصرتُ بهما، إلى مَن شاركتني وكانت حاضرة في صفحات البحث، إلى ابنتي وقرّة عيني
.. فاطمةالزهراء كل الشكر والتقدير.
الباحث
مقدّمة المؤسّسة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقية وسعادته الأبدية المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدد اختيارات الإنسان الصحيحة، وعلى ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله} على سائر المخلوقات، واحتج عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)([1]) ، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، وقد جاء في الأثر «العلمُ نورٌ»([2])، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله، إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)([3])، وبهما تسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله} بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)([4])، و(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) ([5])، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاؤهم^ ومبتغاهم من الله لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»([6]).
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه هي سيرة الأنبياء والأئمة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبي أو وصي، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أنيطت بهم^، كما أخبر} بذلك في قوله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)([7])، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقية سير الأنبياء، كما أنّ سيرة الأئمة^ ليست كبقية سير الأوصياء السابقين، كما أنّ التفاوت في سير الأئمة^ فيما بينهم مما لا شك فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقية الأئمة^.
والإمام الحسين× تلك الشخصية القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة التي دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الرباني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصية العظيمة التي ملأت أركان الوجود تعلَّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفية والعملية، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمس الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قبل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم وأفنوا أغلى أوقاتهم وزهرة أعمارهم لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفية التي تركها× للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفية في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: بل هي أكثر مما تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعددة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤولية المهتمين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق؛ بادرت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكرية والعلمية حول شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى والأساس بمسك هذا الملف التخصصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسية، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، التابعة للعتبة الحسينية المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميين ـ على شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطة مبرمجة وآلية متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلمية التخصصية، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفِّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينية المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصية الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلمية في المؤسسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسَّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلمية في المجال الحسيني، تمّ الوقوف على مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهميته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويات المعتمد في المؤسَّسة تمّ اختيار المشاريع العلمية الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعية للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينية التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلمية وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث المكتوب عن مقتل الإمام الحسين×، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينية). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ ليتمَّ جمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتمُّ استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسَّسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد إخضاعها للتقييم العلمي من قبل اللجنة العلمية في المؤسَّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر تقوم المؤسَّسة بطباعتها.
الثاني: مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية والفقهية والأدبية في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلات العلمية الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلمية الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينية
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونية وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علميّ تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×
وهي موسوعة علمية تخصصية مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون ذلك من خلال جمع كلمات الإمام الحسين× من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية مع بيان لتلك الكلمات، ثمّ وضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام× والواقع العلمي.
الخامس: قسم دائرة معارف الإمام الحسين× أو (الموسوعة الألفبائية الحسينية)
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام وبلدان وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلمية، مكتوبة بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ حديث.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
إنّ العمل في هذا القسم يتمحور حول أمرين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة من قبل اللجنة العلمية في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية، تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
يقوم هذا القسم بمتابعة التراث المكتوب حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة باللغات غير العربية لنقله إلى العربية ومنها إلى لغات أخرى، ويكون ذلك من خلال تأييد صلاحيته للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ترجمته إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينية المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية في شتّى المجالات.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات العلمية
ويتمّ العمل في هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكرية متخصّصة في النهضة الحسينية، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، كما تتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلمية في المؤسَّسة، وكذا سائر الباحثين والمحققين وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينية وفق الأدوات الاستنباطية المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينية التخصصية
وهي مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسَّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصُّصها.
الحادي عشر: قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصِّص بنشر نتاجات وفعاليات مؤسَّسة وارث الأنبياء، يقوم بنـشر وعرض كتبها ومجلاتها التي تصدرها، وكذا الندوات والمؤتمرات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسَّسة، ومجمل فعالياتها العلمية والإعلامية.
الثاني عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصص وبأقلام علمية نسوية في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبية، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الثالث عشر: القسم الفني
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسَّسة، من خلال برامج إلكترونية متطوِّرة يُشرف عليها كادر فنيّ متخصِّص، يعمل على تصميم الأغلفة وواجهات الصفحات الإلكترونية، وبرمجة الإعلانات المرئية والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها كافّة الأقسام.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.
قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء
يتكفّل قسم الرسائل والأطاريح الجامعية بمهمّة نشر الفكر الحسيني المبارك، من خلال تفعيل الدراسات والأبحاث العلمية الحسينية في الأوساط الجامعية والأكاديمية بمستوياتها الثلاثة: البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، مضافاً إلى الرُقي بالمستوى العلمي والتحقيقي للكفاءات الواعدة المهتمّة بالنهضة الحسينية في جميع مجالاتها. وقد تصدّى لهذه المسؤولية نخبة من الأساتذة المحقِّقين في المجال الحوزوي والأكاديمي.
أهداف القسم
الغاية من وراء إنشاء هذا القسم جملة من الأهداف المهمّة، منها:
1ـ إخضاع الدراسات والأبحاث الحسينية لمناهج البحث المعتمَدَة لدى المعاهد والجامعات.
2ـ إبراز الجوانب المهمّة وفتح آفاق جديدة أمام الدراسات والأبحاث المتعلّقة بالنهضة الحسينية، من خلال اختيار عناوين ومواضيع حيوية مواكبة للواقع المعاصر.
3ـ الارتقاء بالمستوى العلمي للكوادر الجامعية، والعمل على تربية جيل يُعنَى بالبحث والتحقيق في مجال النهضة الحسينية الخالدة.
4ـ إضفاء صبغة علمية منهجية متميزة على صعيد الدراسات الأكاديمية، المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة.
5ـ تشجيع الطاقات الواعدة في المعاهد والجامعات؛ للولوج في الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف مجالات البحث المرتبطة بالنهضة الحسينية، ومن ثَمّ الاستعانة بأكفّائها في نشر ثقافة النهضة، وإقامة دعائم المشاريع المستقبلية للقسم.
6ـ معرفة مدى انتشار الفكر الحسيني في الوسط الجامعي؛ لغرض تشخيص آلية التعاطي معه علمياً.
7 ـ نشر الفكر الحسيني في الأوساط الجامعية والأكاديمية.
8 ـ تشخيص الأبعاد التي لم تتناولها الدراسات الأكاديمية فيما يتعلّق بالنهضة الحسينية، ومحاولة العمل على إبرازها في الدراسات الجديدة المقترحة.
9ـ التعريف بالرسائل الجامعية المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ والتي تمّت كتابتها ومناقشتها في الجامعات.
آليات عمل القسم
إنّ طبيعة العمل في قسم الرسائل والأطاريح الجامعية تكون على مستويات ثلاثة:
المستوى الأوّل: العناوين والمواضيع الحسينية
يسير العمل فيه طبقاً للخطوات التالية:
1ـ إعداد العناوين والموضوعات التخصّصية، التي تُعنَى بالفكر الحسيني طبقاً للمعايير والضوابط العلمية، مع الأخذ بنظر الاعتبار جانب الإبداع والأهمية لتلك العناوين.
2ـ وضع الخطّة الإجمالية لتلك العناوين والتي تشتمل على البحوث التمهيدية والفصول ومباحثها الفرعية، مع مقدّمة موجَزَة عن طبيعة البحث وأهميته والغاية منه.
3ـ تزويد الجامعات المتعاقد معها بتلك العناوين المقترَحَة مع فصولها ومباحثها.
المستوى الثاني: الرسائل قيد التدوين
يسير العمل فيه على النحو التالي:
1ـ مساعدة الباحث في كتابة رسالته من خلال إبداء الرأي والنصيحة.
2ـ استعداد القسم للإشراف على الرسائل والأطروحات فيما لو رغب الطالب أو الجامعة في ذلك.
3ـ إنشاء مكتبة متخصِّصة بالرسائل الجامعية؛ لمساعدة الباحثين على إنجاز دراساتهم ورسائلهم، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من مكتبة المؤسَّسة المتخصّصة بالنهضة الحسينية.
المستوى الثالث: الرسائل المناقشة
يتمّ التعامل مع الرسائل التي تمّت مناقشتها على النحو التالي:
1ـ وضع الضوابط العلمية التي ينبغي أن تخضع لها الرسائل الجامعية، تمهيداً لطبعها ونشرها وفقاً لقواعد ومقرَّرات المؤسَّسة.
2ـ رصد وإحصاء الرسائل الأكاديمية التي تمّ تدوينها حول النهضة الحسينية المباركة.
3ـ استحصال متون ونصوص تلك الرسائل من الجامعات المتعاقَد معها، والاحتفاظ بها في مكتبة المؤسَّسة.
4ـ قيام اللجنة العلمية في القسم بتقييم الرسائل المذكورة، والبتِّ في مدى صلاحيتها للطباعة والنشر من خلال جلسات علمية يحضرها أعضاء اللجنة المذكورة.
5ـ تحصيل موافقة صاحب الرسالة لإجراء التعديلات اللازمة، سواء أكان ذلك من قبل الطالب نفسه أم من قِبل اللجنة العلمية في القسم.
6ـ إجراء الترتيبات القانونية اللازمة لتحصيل الموافقة من الجامعة المعنِيَّة وصاحب الرسالة على طباعة ونشر رسالته التي تمّت الموافقة عليها بعد إجراء التعديلات اللازمة.
7ـ فسح المجال أمام الباحث؛ لنشر مقال عن رسالته في مجلة (الإصلاح الحسيني) الفصلية المتخصِّصة في النهضة الحسينية التي تصدرها المؤسَّسة.
8 ـ العمل على تلخيص الرسائل الجامعية، ورفد الموقع الإلكتروني التابع للمؤسَّسة بها، ومن ثَمَّ طباعتها تحت عنوان: دليل الرسائل والأطاريح الجامعية المرتبطة بالإمام الحسين× ونهضته المباركة.
هذه الرسالة: سبي آل البيت^ من الطفّ إلى بلاد الشام سنة 61 هـ/680م (دراسة تاريخية)
إنّ كلّ حادثة عظيمة وواقعة كبيرة لا يمكن أن تُؤثّر بشكل كامل وعميق وواضح إلّا من خلال الإعلام والإعلان، الذي يسلّط الضوء على تلك الواقعة من خلال بيان أهدافها ومبادئها وقيمها وشعاراتها، ومن خلال دفع الشبهات والإشكالات والتزييفات التي يلصقها الأعداء بها.
ونهضة الإمام الحسين× وإن كانت عظيمة من جميع الجهات، بقائدها الفذّ وقيمها ومبادئها النبيلة وأهدافها السامية، إلّا أنّها بحاجة إلى جهاز إعلامي يعلن الحقيقة ويدافع عنها ويبيّنها ويشرحها. ولا بدّ أن يكون هذا الجهاز منبثقاً من نفس الواقعة، ومرتبطاً ارتباطاً عفوياً بها، حتّى يحمل الحكمة والعلم والدقّة مع الصبر والتحمّل والاستقامة والثبات والوضوح، فإنّ المهمّة صعبة وثقيلة وحسّاسة.
فكان الجهاز الإعلامي هو أهل بيت الحسين× وأهل بيت الرسول’، وهو ركب السبايا بقيادة الإمام السجّاد علي بن الحسين÷ والسيّدة زينب أخت الحسين÷، فكان هذا الركب يحمل روح الحسين× وقيم الحسين× وأهداف الحسين×.
كان هذا الركب التصريح الرسمي لوقعة كربلاء، فامتدّت مسيرته من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى الشام ومنها إلى الكوفة ومنها إلى المدينة، وعلى طول هذه المسيرة البعيدة كانت حناجر أهل البيت^ تصرح بالخطب والكلمات والبيانات التي تشرح وتغيّر وتعلن وتعلم عمّا وقع في كربلاء ولماذا كانت كربلاء. كما أنّه قد رافق السبي في هذه المسيرة الظلم والاضطهاد من الضرب والشتم والتزوير وكلّ ما هو قبيح.
وقد سلّط الباحث في هذه الرسالة الضوء على هذا الموضوع المهم والمصيري في الفكر الإسلامي؛ لما له من تأثير كبير في تغيير مجريات الأمور منذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا.
وفي الختام نسأل الله تعالى للمؤلِّف دوام السَّداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلمية في
مؤسسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية قسم الرسائل الجامعية
مقدّمة قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، وأشرف بريّته محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.
لا يخفى أنّ الصراعَ بين الحقّ والباطل يُعدُّ من السنن الثابتة، وقد عانى المسلمون مآسي هذا الصراع، لا سيّما في فترة الحكم الأموي الذي أدّى بالأمّة الإسلامية إلى الرجوع إلى ما قبل شروق أنوار الرسالة. وقد كاد حكمهم يقتلع الدين الإسلامي ويزيله من أذهان المسلمين، لولا انطلاقة سيّد الشهداء الإمام الحسين×، الذي وقف بنهضته المباركة بوجه الطغيان والجبروت.
فكانت النهضة الحسينية المباركة من أعظم الثورات الإصلاحية التي عرفها التاريخ البشري على وجه الكرة الأرضية؛ وذلك لأنّها استطاعت أن تحفظ الرسالة من الانحراف، وتُحيي المبادئ والقِيم المقدّسة في عقول ونفوس الأجيال المتعاقبة. فهي بحقّ مدرسة أثّرت في الإنسانية بالمبادئ السامية التي تجسّدت في مواقف الإمام الحسين× ومواقف أصحابه وأهل بيته، كالتضحية والإخلاص والإباء والثبات على المبدأ الحقّ، وعلوّ الهمّة والوفاء والعزم والشجاعة، وبذل النفس والنفيس في سبيل الله، وغيرها من القِيم النبيلة.
ولذلك نجد أنّ الاجيال المتعاقبة من المؤمنين قد اغترفوا من نمير هذه المدرسة الإلهية، واكتسبوا منها العزم على مواجهة التحديّات المعاصرة التي تلفّ بالشيعة من كلّ حدب وصوب.
ومن هذا المنطلق بادر قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، إلى السعي الحثيث لإدخال الثقافة الحسينية ونشرها في الوسط الجامعي، فقام في اُولى خطواته بجمع الأطاريح والرسائل الجامعية المرتبطة بالنهضة الحسينية، ومراجعتها وتدقيقها واجراء التعديلات اللازمة عليها؛ لتكون مادّة بحثيّة تُوضع في متناول أيدي القرّاء بصورة عامّة والباحثين بصورة خاصّة.
وهذه الرسالة الموسومة بـ «سبي آل البيت^ من الطفّ إلى بلاد الشام سنة 61هـ/680م (دراسة تاريخية)» من بين الرسائل التي اعتنى بها قسم الرسائل، فقامت اللجنة العلمية في هذا القسم بمراجعتها واجراء بعض التعديلات الضرورية لإظهارها بهذا الشكل الماثل بين يدي القارئ الكريم.
وقد تناول الباحث في هذه الرسالة التعريف بمفهوم السبي ومفهوم آل البيت^، وعدد السبايا اللواتي تمّ سبيهنّ من عائلة الإمام الحسين× ونساء أنصاره، اللائي صحبنه من المدينة المنوّرة على ضوء ما جاء في المصادر التاريخية. وكذلك تناول عدد الرؤوس من شهداء الطفّ من الهاشميين وغيرهم، والتي تمّ قطعها بأمر عمر بن سعد، وحملَها بعض القبائل لإيصالها إلى عبيد الله بن زياد والي الكوفة آنذاك، كلّ ذلك لأجل التقرّب إلى هذا الطاغية.
وتعرّض الباحث كذلك إلى كيفية استعراض سبايا آل البيت^ في شوارع الكوفة، ومواقف أهل الكوفة لمّا رأوا السبايا من آل البيت^ وهم في هذه الحال، بالإضافة إلى خطبة السيّدة زينب بنت علي÷ في أهل الكوفة، وخطبة السيّدة فاطمة بنت الحسين÷، وخطبة أم كلثوم بنت علي÷، وبيان مضامين هذه الخطب ومدى تأثيرها في توعية النّاس وتعريفهم بحقيقة الأمور.
وكذلك كرّس قسماً من البحث لخطبة الإمام علي بن الحسين÷، ودورها في إثارة مشاعر الحزن والبكاء، ممّا أدّى إلى تحريك ضمائر الكثير من النّاس وإبداء أسفهم على خذلانهم للإمام الحسين×. بالإضافة إلى مباحث أخرى.
وقد تميّزت هذه الرسالة بدقّة عنوانها وتسلسل مباحثها ووفرة مصادرها وعمق تحليلها، حيث عكس الباحث الأحداث التي حصلت مع السبايا بالتحليل والتفصيل، وقد توصّل إلى نتائج مهمّة، من قبيل: أنّ الهدف من سبي آل البيت^ واستعراضهم بالشوارع هو لأجل بيان أنّ الإمام الحسين× هو رجل خارجي خرج عن طاعة الخليفة، مضافا إلى إدخال الرعب في قلوب النّاس. وكذلك ما أحدثته خطب الإمام السجّاد× والسيّدة زينب‘ وغيرها من آل البيت^ من قلب الموازين على السلطة الحاكمة.
اللجنة العلمية في
قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
مؤسّسة وارث الأنبياء
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله الكريم المنّان، الذي أنزل كتابه بالحقّ نوراً وهدى لعباده وأنزل الميزان، فهدى النّاس بهذا النور من ظلمات الشرك وعبادة الأوثان، فأصبح قومٌ بفضل هدايته سادة الدنيا وملوك الزمان، ونصلّي ونسلّم على أفضل الأنبياء والمرسلين محمّد، سيّد ولدِ عدنان، الذي ختم الله به الشرائع وأكمل الأديان، فبلّغ هذا النبيُّ ما أنزل إليه من ربه بأجزل بيان، فأزال به غُلْف القلوب وعَمَى الأعين وصمَمَ الآذان، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، أئمّة الهدى وأعلام الدين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وعلى أصحابه المنتجبين، الذين أهتدوا بهديه إلى يوم الدين...
أمّا بعد...
إنَّ إعلان الإمام الحسين× ثورته على الأمويين، كانت من أجل الحفاظ على الشريعة الإسلامية وتعاليمها وعلى الأمّة ومصالحها، تجاه كلّ الإنحرافات التي ظهرت فيها، وهذا ما تُحمّله المسؤولية الدينية عليه، باعتباره إمام الأمّة وفقاً لقول الرسول’: «الحسن والحسين إماما أمّتي، بعد أبيهما، وسيّدا شباب أهل الجنّة»([8])، فضحّى بنفسه وولده وإخوته وأبنائهم وأبناء عمومته وعدد من أنصاره من غير الهاشميين في سبيل ذلك، وقد أحدثت هذه الواقعة الشجيّة ـ ولازالت ـ جروحافيالنفوسالنقيةلاتندمل، وكلّماتجدّد سقف الزمن تزداد مساحة هذه المأساة أسى ولوعة، وآفاقها سمواً وفخراً...
وكانت تجربة الطفّ الرائدة تحمل حرارة صدق الجهاد، ووضوح رؤيته النضالية، فكان لهذه التجربة صداها الواسع على امتداد مراحل التاريخ، وفي كلّ صفحة من صفحاتها، ومن بين تلك الصفحات المؤثّرة في ضمير التاريخ هو سبي آل البيت^ من الطفّ إلى بلاد الشام، ولم تنتهِ تلك الصفحات وإلى يومنا هذا.
وبسبب الحال الذي تمرّ به الأمّة الإسلامية، نجد أنّنا بحاجة كبيرة إلى مراجعة ثورة الإمام الحسين× بين حين وآخر؛ لننهل من معينها الصافي الذي لا ينضب، ولنأخذ منه العبرة والحكمة على ما حدث في حينها، وما يحدث الآن في وقتنا الحاضر. ولابد من تدقيق فيما رُوي وكُتب عنها؛ لإزالة كلّ ما علق فيها من شوائب دُسّت فيها، وإظهارها نقيّة كما وقعت أحداثها، وذلك لأنّ التاريخ قد تعرّض للتحريف والتزوير الذي طال سيرة تلك الأنوار العطرة، فتعرّضت سيرتهم إلى التشويه أو الكتمان. كلّ هذا من أجل إسكات صوت الحقّ ونصرة المظلوم، وزرع الإحباط والإنكسار في نفوس المظلومين للاستهانة بمثل تلك الثورات حتى لا تتّخذ مثلا يُقتدى به، ولا تنتشر في أماكن أخرى ممّا دعا الكثيرَ ممَّن أُتيح له فرصة التأليف والكتابة، خاصّة في هذه الحقبة السياسية، التي تشهد نوعاً من الانفراج والحرية في التعبير عن الرأي، أن ينبروا للكتابة عن شخصيات أهل البيت^، لإظهار دورهم في المجتمع الإسلامي، وليزيلوا عن سيرتهم ذلك الضباب والتعتيم والكتمان، الذي فرضته الحكومات المتعاقبة من زمن الدولة الأموية وإلى فترة قريبة.
وأمّا نساء أهل البيت^، اللواتي تمّ سبيهنّ من الطفّ إلى بلاد الشام، فعلى الرغم من كونهنّ سيّدات بيت النبوّة قد غُيّبت عن التاريخ حقائق كثيرة فيما يتعلّق بهنَّ، وعن مدى ما تعرضنَ إليه من ظلم وعدوان فادح خلال فترة السبي.
ثم إنّ سبي آل البيت^ بنقلهم من الطفّ إلى الكوفة ومن ثمّ إلى الشام ورجوعهم إلى المدينة المنوّرة، كان له آثار سياسية وفكرية واجتماعية قد انعكست على أهل الكوفة والشام، وعلى كلّ مدينة وقرية مرّوا بها خلال مدّة سبيهم، كما كان له صداه الإعلامي في نشر مظلومية آل البيت^، وما تعرّض له هذا البيت من جريمة لا تُغتفر أثارت الرأي العام على الأمويين، وخاصّة في عاصمتهم دمشق، تلك الفضيحة الشنيعة التي أثارت أهالي دمشق أولاً ومن ثمّ مدن وأقاليم دولتهم الأخرى.
ولمّا كان جلّ السبايا من النساء والأطفال فإنّه يتعارض مع المبادئ الإسلامية التي رفع راياتها الأمويون كمازعموا، بل يتعارضمع أبسط خلق إنساني عربي عرفه العرب قبل الإسلام.
ولمّا كان الجهاد الفكري والإعلامي، الذي قام به سبايا آل البيت^ في تلك الظروف الاستثنائية، قد أبرز شخصياتهم ذات المؤهّلات العالية، فأحدث وجودهم وأعمالهم في تلك الحال هزّة عنيفة في ضمير الأمّة، فأيقظته من السبات، كما كانت خطبهم التي وُصِفت بالجهاد الفكري في تلك الظروف، صرخة مدوّية في وجه الإنحراف، فتمكّن من إسقاط أقنعة الزيف والخداع الذي أشاعته ماكنة الإعلام الأموي، فانكشف وجه الحقيقة لِمَن خُدِع أو التبس عليه الأمر، فكان عملهم بمثابة إلقاء الحجّة عليهم، وهذا هو ما قام به سبايا آل البيت^ في تلك المرحلة من مراحل النهضة الحسينية، والتي هي المكمّلة لما ابتدأه الإمام الحسين×.
وهذا ما دفعنا إلى التشرّف في أن يكون موضوع هذا البحث هو (سبي آل البيت^ من الطفّ([9]) إلى بلاد الشام 61هـ/680م (دراسة تاريخية)).
ولم تنحصر أهمية الموضوع فيما تقدّم فقط، بل إنّ هناك أسباباً أخرى دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، تكمن في أمرين هما:
أولهما: لم يُبحث الموضوع بحثاً علمياً أكاديمياً شاملا لكلّ جوانبه، في حدّ علمي المتواضع، كما أنّ معظم الدراسات والأبحاث التي تمّ كتابتها عن معركة الطفّ وما بعدها، وحتى الآن لم تبحث سبي آل البيت من الطفّ إلى بلاد الشام، أو تتناولها بدراسة تاريخية أكاديمية كاملة وشاملة لجميع جوانب هذا الموضوع، بل اكتفى أغلبها بدراسة إحدى شخصياتها، أو تناولها لأحد الأدوار التي قام به السبايا بعد معركة الطفّ، كما جاءت تلك الدراسات في نواحٍ كثيرة منها، وخاصّة فيما يتعلّق بعملية سبي آل البيت^ بصورة مقتضبة، وسنشير لاحقاً لأهمّ تلك الدراسات.
وثانيهما: إنّ موضوع السبي لم تُسلّط عليه الأضواء من قبل المؤرِّخين المعاصرين للحدث، بالقدر الذي سلّط على الفاجعة الكبرى، وهي قتل الإمام الحسين× وآل بيته^ وأبناء عمومته وأنصاره، والتي كانت صدمة للعالم الإسلامي، عاشها لسنين طويلة بعد يوم عاشوراء.
بالرغم من كثرة المصادر التي تروي معركة الطفّ، غير أنّها لم تتطرّق إلى سبايا آل البيت^ بشكل واضح، وإنّما تشير أغلب المصادر بشكل إجمالي إلى بعض الأحداث، وتجاهلها أحداثاً كثيرة أخرى.
ثمّ إنّ العديد من المراجع التي تمّ تأليفها في القرون المتأخرة، والتي أشارت إلى سبايا آل البيت^بشكل أو بآخر، نجدها تورد روايات، وعند الرجوع للمصادر الأولية التي أخذت منها، لا نجد تلك الروايات في طيّاتها أو ما يشير إليها. بعبارة أخرى: إنّها تحتوي على روايات لا أساس لها، وهي الروايات الشفوية التي احتوتها كتبهم، وسمعوها من هنا وهناك، أو من بعض الخطباء وقرّاء المراثي الحسينية، وتارة نجدهم يذكرون إضافات لا تنسجم مع معركة الطفّ، وتتعارض مع أهدافها، إلّا أنّ هذا لايعني أنّ جميع معلومات هذه الكتب خاطئة.
لقد انتظم البحث في خمسة فصول، سبقتها مقدّمة وتمهيد، وتلتها خاتمة وعدد من الملاحق وثبتٌ للمصادر والمراجع.
تناول التمهيد وبإيجاز: الأحداث التي أدّت إلى ثورة الإمام الحسين بن علي÷، وقتله ورجال بيته وأنصاره في الطفّ، ممّا أدّى إلى سبي آل البيت^.
وتناول الفصل الأول: سبي آل البيت^ من الطفّ إلى الكوفة، وقُسِّم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث رئيسة،أمّا المبحث الأول، فقد تحدّث عن معنى السبي لغةً واصطلاحاً؛ والمبحث الثاني، تحدّث عن مفهوم آل البيت^ لغةً واصطلاحاً، وتحديد مَن هم آل البيت^، وفقاً لما جاء في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة. والمبحث الثالث، تحدّث عن بدء السبي والوصول إلى الكوفة، إذ سُبي آل البيت^ من الطفّ، ونُقِلوا إلى الكوفة، حتى وصلوا إلى مشارفها، وبالتحديد إلى الموضع المسمّى بالحنّانة، الذي لا يبعد كثيرا عن مركز المدينة. كما استعرض هذا المبحث أعداد السبايا اللواتي تمّ سبيهنّ، من نساء عائلة الإمام الحسين بن علي÷، اللائي صحبنه من المدينة المنوّرة، مضافا إلى شبابهم وصبيانهم، وفق ما جاء في المصادر الأولية والثانوية، ومناقشة الروايات والآراء التي جاءت فيها. كذلك تطرّق إلى عدد رؤوس قتلى الطفّ من الهاشميين و غيرهم، التي تمّ قطعها بأمر من عمر بن سعد ظهر الحادي عشر من المحرم، وحملها من قبل بعض القبائل لإيصالها إلى والي الأمويين على الكوفة عبيد الله بن زياد، للتقرب منه ونيل جائزته.
وتناول الفصل الثاني: سبايا آل البيت^ في الكوفة، وما تركوه من أثر في المجتمع الكوفي، ذلك الأثر الذي أدّى إلى تغيّرات اجتماعية وفكرية وسياسية، حيث انتهج سبايا آل البيت^في الكوفة منهج الجهاد الفكري، من خلال خطبهم التي ألقوها في حشود أهل الكوفة منذ دخولهم حتى خروجهم منها، وقُسّم هذا الفصل إلى سبعة مباحث،أمّا المبحث الأول، فقد تحدّث عن كيفية استعراض السبايا^ في شوارع الكوفة، ومواقف أهل الكوفة عند رؤيتهم أهل البيت^ بهذه الحالة. والمبحث الثاني، تحدّث عن خطبة السيّدة زينب بنت علي÷في أهل الكوفة التي ألقتها، تلك الخطبة التي وُصِفت ببلاغتها وفصاحتها، وبيان أهم المضامين التي تطرّقت إليها، وخاصّة فيما يتعلّق بوصفها لأهل الكوفة بالغدر والخيانة. والمبحث الثالث، تحدّث عن خطبة السيّدة فاطمة بنت الحسين÷في أهل الكوفة، التي أتّسمت ببيان قوتها وروعتها بالرغم من صغر سنّها، فقد برزت فيها معالم الوراثة النبوية، والتي دحضت من خلالها كلّ مزاعم أهل الكوفة، وبيّنت غدرهم ونقضهم لبيعة الإمام الحسين×، وأوضح المبحث الأثر النفسي الذي تركته الخطبة في أهل الكوفة. والمبحث الرابع، تحدّث عن خطبة السيّدة أم كلثوم بنت علي ÷ في أهل الكوفة، حيث كان لخطبتها أكبر الأثر في توعية النّاس، وتعريفهم بحقيقة الأمور، وبأنّهم آل البيت لا خوارج كما ادَّعى يزيد بن معاوية وأعوانه. والمبحث الخامس، تحدّث عن خطبة الإمام علي بن الحسين (السجاد×)، ووضّح أهمّ ما اتّسمت به، فقد كانت إغترافاً من نهج الآباء والأجداد وامتداداً له، تلك الخطبة التي أدّت بالنّاس إلى أنْ يتأثّروا تأثّراً كبيراً، وتزداد أحزانهم، وتلتهب مشاعرهم، فتحرّكت ضمائرهم مؤنّبة إياهم على خذلانهم للإمام الحسين× وأهل بيته. وأمّا المبحث السادس، فقد تحدّث عن دخول سبايا آل البيت^ قصر الإمارة، وبيان الأهداف التي كان يتوخّاها ابن زياد من ذلك، من خلال حواره مع السبايا، وتوضيح كيف تمكّن كلّ من الإمام علي بن الحسينوعمّته السيّدة زينب÷ من إفشال كلّ مخططاته، إذ إنّه قابل شخصيتين قويتين مسلحتين بالصبر والإيمان، تمكنتا فكرياً بالأدلة القرآنية من هزيمته. ثمّ ينتهي هذا اللقاء بقرار ابن زياد بإرسال السبايا إلى السجن. وينتهي الفصل الثاني بالمبحث السابع، الذي تحدّث عن ردود الأفعال، وأهم مظاهر الآثار التي تركها سبايا آل البيت^ على أهل الكوفة، والمتمثّلة بأصداء المعارضة التي تردّدت استنكاراً لما فعله ابن زياد برأس الإمام الحسين×، وسبايا آل البيت^، وكيف أخذت بالتزايد حتى وقوع المواجهات العسكرية بين أتباع ابن زياد والمعارضين له. ثمّ خُتِم هذا الفصل بالحديث عن مدّة بقاء سبايا آل البيت^في الكوفة قبل تجهيزهم وإرسالهم إلى مقرّ السلطة الأموية في الشام.
وتناول الفصل الثالث: سبي آل البيت^ من الكوفة إلى بلاد الشام، الذي ترك آثاراً وتحوّلات فكرية وسياسية وعسكرية في بعض المدن، التي مرّت بها قافلة سبايا آل البيت^، إذ كانت رافضة لأفعال بني أميّة. وقُسِّم هذا الفصل إلى أربعة مباحث،أمّا المبحث الأول، فقد تحدّث عن الأمراء الذين رافقوا قافلة سبايا آل البيت^ من الكوفة إلى الشام، والطريقة التي تمّ بها إخراج السبايا من الكوفة، والإجراءات التي اتّخذها ابن زياد تحسّبا لوقوع أيّ طارئ في الطريق. والمبحث الثاني، تحدّث عن الطرق بين الكوفة ودمشق، وترجيح الطريق الذي سلكته قافلة السبايا، والهدف من ذلك، بالاعتماد على القرائن والأدلة التي تمكّنا من جمعها بهذا الصدد. والمبحث الثالث، تحدّث عن مسير سبايا آل البيت^من الكوفة إلى دمشق، ومنازل الطريق التي مرّوا بها، وأهمّ الأحداث والمواجهات العسكرية التي حدثت خلال مرورهم بتلك المدن. والمبحث الرابع، تحدّث عن وصول سبايا آل البيت^ إلىدمشق، والمدّة التي بقوها خارج دمشق وقرب أسوارها، وكيفية عرضهم في دمشق، وأهمّ الأحداث التي جرت خلال استعراض السبايا.
وتناول الفصل الرابع: سبايا آل البيت^ في مجلس يزيد بن معاوية، فقد بحثنا فيه الجهاد الفكري لسبايا آل البيت^، والآثار التي تركوها في المجتمع الشامي، والمتمثّلة بالتحوّلات الفكرية والتغيّرات التي حصلت في المواقف السياسية، منذ وصولهم عند درج باب الجامع الأموي حتى خروجهم من دمشق، والكيفية التي تمكّن فيها الإمام علي بن الحسين÷ وعمّته السيّدة زينب‘ من ذلك. وقُسِّم هذا الفصل إلى أربعة مباحث، أمّا المبحث الأول، فقد تحدّث عن الأحاديث الأولى لسبايا آل البيت^ مع يزيد في مجلسه، وما تركته من تأثير عميق في نفوس الحاضرين. والمبحث الثاني، تحدّث عن خطبة السيّدة زينب بنت علي÷ في مجلس يزيد، ووضّحنا أهم المقاصد التي كانت السيّدة زينب‘ تتوخّى نشرها بين الحاضرين في مجلس يزيد، والتي مهّدت لإحداث تغيير كبير في المفاهيم والتوجهات الفكرية عندهم. والمبحث الثالث، تحدّث عن خطبة الإمام علي بن الحسين (السجاد×) في مجلس يزيد، ووضّحنا فيه فقراتها وأهدافها ومضامينها، والأسلوب الحكيم والواعي الذي اتّبعه في خطبته، إذ وجّه كلامه إلى الحاضرين في مجلس يزيد، معرِّفاً بنفسه وأهل بيته، وما يحملونه من صفات أخلاقية، وما قدّموه من تضحيات في سبيل نشر الإسلام، وما منحهم الله تعالى من الفضل والصفات التي ميزتهم عن غيرهم من البشر، ممّا كان له الأثر الكبير في توعية الحاضرين وتغيير اتجاههم الفكري، بحيث أنارت عقولهم، ووضّحت لهم الحقائق التي كانت غائبة عنهم، من أنّهم ليسوا بخوارج كما قيل لهم، بل من أهل بيت الوحي. والمبحث الرابع، تحدّث عن أهمّ مظاهر تأثير سبايا آل البيت^على المجتمع الشامي وردود أفعالهم، المتمثّلة بأصداء الرفض لفعل يزيد بن معاوية، الذي لم يقتصر على المسلمين بل شمل عدداً من الشخصيات غير المسلمة أيضا، ممّا أدّى إلى قتل يزيد لبعضهم؛ لإسكات وإخماد صيحات الرفض التي تعالت بوجهه ردّا على فعله حتى لا تنتشر أو يسمع بها غيرهم، فضلاً عن تحديد مدّة بقاء سبايا آل البيت^في الشام قبل خروجهم منها.
وتناول الفصل الخامس: رأس الإمام الحسين بن علي÷ ومدفنه. وقُسِّم إلى مبحثين، أمّا المبحث الأول، فقد تحدّث عن قطع الرؤوس وأبعاده السياسية والاجتماعية، موضحين فيه دخالة هذه الثقافة على الإسلام التي لم تكن موجودة في عهد رسول الله’ ولا حتى في العصر الراشدي، وبيّنا هدف بني أميّة من نشر مثل هذه الثقافة وأثرها في المجتمع الإسلامي. والمبحث الثاني، تحدّث عن مدفن رأس الإمام الحسين بن علي÷في أماكن متعدّدة، في دمشق وعسقلان ومصر والمدينة والغري (النجف)، والطف الذي نميل إليه في دفن الرأس إلى جانب الجسد.
وأخيراً تأتي الخاتمة، التي تضمّنت أهمّ النتائج التي توصّل إليها الباحث من خلال الدراسة. ودُعِم البحث بعدد من الخرائط والمخطّطات التوضيحية.
تلك هي الخطوط العريضة لأبرز المواضيع التي تناولتها هذه الرسالة، بالدراسة وصفاً وإحصاءً وتحليلاً واستنتاجاً، ولا بدّ من القول بأنّنا لا ندّعي إيفاء هذا الموضوع حقَّه، أو الإحاطة بجميع جوانبه، فإنّنا وإن لم نكن قد بلغنا الغاية المرجوة في هذا البحث، إلّا أنّ أملنا أن نكون قد وفّقنا في بعض ذلك.
اعتمدت الدراسة على مصادر ومراجع متنوّعة، أغنت الرسالة بوافر معلوماتها وكثرة أخبارها في حدث تاريخي له من الأهمية ما لا ينكره أحد، طغى على كثير من الأحداث التي زخر بها التاريخ الإسلامي على وجه العموم وتاريخ دولة بني أميّة على وجه الخصوص، إذ تنوّعت مصادر الرسالة وأدبياتها على وفق طبيعتها وألوانها، على الرغم من أنّ بعضها يمدّنا بشذرات قليلة عن حادثة سبي آل البيت^ في جانب معين دون الآخر.
تُقسّم تلك المصادر على خمسة مجاميع: كتب المقاتل، كتب الحوليّات، كتب التراجم والطبقات، وكتب الرحلات، فضلاً عن عدد من المراجع والدراسات الحديثة. فيما يلي عرض لأهمّها، مرتبين ذلك وفقاً لوفيّات مصنِّفيها:
تُعدّ مصنّفات المقاتل من أبرز الكتب التاريخية التي اهتمّت بثورة الإمام الحسين×، منذ خروجه من مدينة جدّه النبي’ حتى مقتله في الطفّ، وأشار معظمها إلى أثر هذه الثورة على الأحداث التي وقعت بعد معركة الطفّ، وأغنت هذه المصنّفات البحث في جميع فصوله بالمعلومات القيّمة على الرغم من تجاهلها لبعض الأحداث، أو اكتفائها بالإشارة المقتضبة لبعضها الآخر. ومن أهمّها:
1. رسالة (تسميّة مَن قُتل مع الإمام الحسين× من ولده وإخوته وأهل بيته وشيعته)، لفضيل بن الزبير بن عمر، (كان حيّا سنة 145هـ/ 762م).
2. (مقتل الحسين)([10])، لأبي مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الغامدي الأزدي، (ت157هـ/773م).
3. (مقتل الحسين)، للموفق بن أحمد بن محمّد الخوارزمي، (ت568هـ/ 1172 م).
4. (مثير الأحزان)، لابن نما جعفر بن محمّد بن جعفر الحلي (ت645هـ/ 1247م).
5. (اللهوف في قتلى الطفوف)، لعلي بن محمّد بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس، (ت664هـ/1265م).
أمّا كتب التأريخ ـ الحولية وغير الحولية ـ فقد أفاد منها الباحث فائدة جمّة، فقد زوّدته في عرض الوقائع التاريخية، ويأتي في المقدّمة منها:
1. (الإمامة والسياسة)، المنسوب لأبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، (ت276هـ/889م).
2. (الأخبار الطوال)، لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري، (ت282هـ/ 895م).
3. (التاريخ)، لأحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب اليعقوبي، (ت292هـ/905م).
4. (تاريخ الرُسُل والملوك)، لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبري، (ت310هـ/922م).
5. (الفتوح)، لأبي محمّد أحمد بن أعثم الكوفي، (ت314هـ/926م).
6. (التنبيه والإشراف)، و(مروج الذهب ومعادن الجوهر)، وكلاهما لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي، (ت346هـ/956م).
7. (تجارب الأمم وتعاقب الهمم)، لأبي علي أحمد بن محمّد مسكويه، (ت421هـ/ 1030م).
8. (تاريخ مدينة دمشق)، لأبي القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر، (ت571هـ/1175م).
9. (المنتظم في تاريخ الأمم والملوك)، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، (ت597هـ/1200م).
10. (الكامل في التاريخ)، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري، (ت630هـ/1232م).
11. (تذكرة الخواص)، لشمس الدين أبو المظفر يوسف بن فرغلي سبط ابن الجوزي، (ت654هـ/1256م).
12. (البداية والنهاية في التاريخ)، لعماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر ابن كثير الشافعي، (ت774هـ/ 1372م).
ثالثاً: مصنّفات الأنساب والتراجم والطبقات
أمّا كتب الأنساب والتراجم والطبقات، فقد أفدنا منها في ترجمة كثير من الشخصيّات التي ورد ذكرها في طيّات البحث، فضلاً عن المعلومات التي وردت فيها عن حادثة السبي، ومن أبرزها:
(الطبقات الكبرى)، لمحمّد بن منيع بن سعد، (ت230هـ/844م).
1. (أنساب الأشراف)، لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، (ت279هـ/ 892م).
2. (الاستيعاب في معرفة الأصحاب)، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد ابن عبد البر، (ت463هـ/1070م).
3. (أُسد الغابة في معرفة الصحابة)، لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم بن الأثير الجزري، (ت630هـ/1232م).
رابعاً: المصنّفات الجغرافية والبلدانية والرحلات
إنّ المصنّفات الجغرافية أفادت البحث كثيراً من خلال ما قدّمته من معلومات، أغنت البحث فيما يتعلّق بالوصف الجغرافي للمدن والمواضع التي مرّت بها قافلة سبايا آل البيت^، فضلاً عن اشاراتها إلى الأحداث التاريخية التي تتعلّق بمرور قافلة السبايا في تلك المدن. ومن بين أهمّ تلك المصادر:
1. (البلدان)، لأحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب اليعقوبي، (ت292هـ/ 905م).
2. (الإشارات إلى معرفة الزيارات)، لأبي الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي، (ت611هـ/1214م).
3. (رحلة ابن جبير)، لأبي الحسين محمّد بن أحمد بن جبير البلنسي، (ت614هـ/1217م).
4. (معجم البلدان)، لشهاب الدين بن عبد الله ياقوت الحموي الرومي، (ت626هـ/1228م).
5. (تقويم البلدان)، لأبي الفداء عماد الدين اسماعيل بن علي بن محمود، (ت732هـ/1331م).
6. (مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع)، لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحقّ البغدادي، (ت739هـ/1338م).
7. (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار)، لمحمّد بن عبد الله بن بطوطة اللواتي، (ت779هـ/1369م).
خامساً: مصنّفات اللغة العربية والأدب
قد أفادت معاجم اللغة العربية البحث؛ لما قدّمته من شرح وتوضيح لكثير من الكلمات التي جاءت في البحث، خاصّة في الفصل الثاني والرابع، فقد اعتمدنا عليها في شرح خطب سبايا آل البيت^، وتوضيح معانيها ومضامينها والمقاصد التي كان يتوخّاها سبايا آل البيت في خطبهم، ومن أهمّها:
1. (العين)، للفراهيدي، (ت175هـ/791م).
2. (الصحاح)، للجوهري، (ت393هـ).
3. (لسان العرب)، لابن منظور، (ت711هـ/1311م).
أمّا المراجع الحديثة، فكان لها دور كبير في إغناء الرسالة في كثير من الآراء، ووصفها للوقائع التاريخية. منها:
1. (معالي السبطين)، لمحمّد مهدي المازندراني، (ت1358هـ/1939م).
2. (زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين)، و (فاطمة بنت الحسين)، وكلاهما لجعفر النقدي، (ت1366هـ/1947م).
3. (أعيان الشيعة)، لمحسن الأمين، (ت1371هـ/ 1952م).
4. (وسيلة الدارين في أنصار الحسين)، لإبراهيم الزنجاني، (ت1351هـ/ 1932م).
5. (مقتل الحسين)، لعبد الرزاق المقرّم، (ت1391هـ/1971م).
6. (السيّدة زينب)، لبنت الشاطئ عائشة عبد الرحمن، (ت1418هـ/1998م).
سابعاً: الرسائل والأطاريح الجامعية
أمّا الدراسات التي تناولت ثورة الإمام الحسين×، والتي قدّمتها الرسائل والأطاريح الجامعية؛ فقد أفدنا منها كثيراً في إعطاء صورة تحليلية عن الحوادث التي وقعت قبل عملية السبي، كما أنارت لنا الطريق في بعض جوانب البحث، ومن أهمّها:
1. (ثورة الإمام الحسين× وأثرها على حركات المعارضة حتى عام 132هـ)، رسالة ماجستير لمروان عطية مايع الزيدي.
2. (ثورة الإمام الحسين في المصنّفات المصرية في القرن العشرين الميلادي)، أطروحة دكتوراه لهادي عبد النبي التميمي.
3. (مسيرة الإمام الحسين إلى كربلاء ـ دراسة تحليلية)، رسالة ماجستير لأحمد عليوي صاحب.
4. (دور نساء آل البيت السياسي والفكري في معركة الطفّ وما بعدها)، أطروحة دكتوراه لأمل محمّد خضر.
5. (السيّدة زينب‘ ودورها في أحداث عصرها)، رسالة ماجستير لهناء سعدون جبار العبودي.
6. (خطب وأقوال أهل البيت في واقعة الطفّ دراسة تاريخية)، رسالة ماجستير لإيمان أحمد جابر اللامي.
وهناك كثير من المصادر والمراجع والدوريات والبحوث التاريخية التي استعنا بها في كتابة هذا البحث المتواضع، يمكن التعرّف عليها بشكل أدقّ ومفصّل من خلال الإطلاع على ثبت المصادر والمراجع.
وأخيراً لا نزعم أنّنا استطعنا الإحاطة بكل دقائق ما يتعلّق بالحوادث التي حصلت لسبايا آل البيت^؛ لأنّ هذه الحادثة أوسع وأشمل من أن يتمكّن باحثٌ من الإلمام بها، فهذا جهد مقلّ نقدّمه معترفين بعدم الكمال، وقيل قديماً: «إنّي رأيت أنّه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلّا قال في غده: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زِيد كذا لكان يستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العِبَر، وهو دليل استيلاء النقص على جملة البشر»([11]).
وختاماً فهذا عمل متواضع نضعه أمام أساتذتنا من أعضاء لجنة المناقشة ليبيّنوا لنا كلّ هفوَة وقعنا فيها، لنزداد فخراً بسماع توجيهاتهم وآرائهم، ونأخذ بها لتصحيح ما وقعنا فيه من زلل؛ لتزداد الرسالة قيمة ورصانة علمية أكبر.
وآخر دعوانا أن الحمد لله تعالى رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
الباحث
يهدف هذا التمهيد إعطاء صورة عن التحوّلات السياسية والاجتماعية في الكوفة (40ـ60هـ/660ـ 679 م)، وأسبابها التي أدّت إلى مقتل الإمام الحسين ابن علي÷، وسبي عياله، والعلّة التي من أجلها أخرجهم.
إنَّ استشهاد الإمام علي بن أبي طالب× سنة 40هـ/661م([12]) على يد الخوارج كان تحوّلاً سياسياً كبيراً في العالم الإسلامي، وأدّى إلى نتائج وخيمة تعرّضت لها الأمّة الإسلامية. ولم يتمكّن الإمام الحسن× من الاستمرار في خلافته التي تولّاها بعد أبيه إلّا حوالي ستّة أشهر؛ وذلك لتفرّق أصحاب أبيه وأصحابه عنه، لعدم طاعتهم له، فترك الكوفة وتوجّه إلى المدينة ليستقرّ فيها هو وعائلته([13])، وذلك لانّ الظروف لم تكن مؤاتية للاستمرار في توليّه الخلافة، ممّا أضطرّه إلى عقد الصلح مع معاوية بن أبي سفيان سنة 41هـ/662م([14])، وسُمّي هذا العام بعام الجماعة([15])، والحقيقة أنَّ هذا العام لم يكن عاماً للجماعة؛ بل عاماً للفرقة والقهر والغلبة، والعام الذي تحوّلت فيه الإمامة ملكاً كسروياً، والخلافة غصباً قيصرياً، عام الجمع للظلام والفسق([16]). ويعلّق عباس محمود العقاد على معاوية وعامهِ بقوله: «ولو حاسبه التاريخ حسابه الصحيح لما وصفه بغير مفرّق الجماعة، ولكنّ العبرة لقارئ التاريخ في زنة الأعمال والرجال، أن تجد من المؤرِّخين مَن يسمّي عامه حين انصرف بالدولة عام الجماعة؛ لأنه فرّق الأمّة شيعاً شيعاً»([17]).
تضمّن الصلح الذي أُبرِم بين الإمام الحسن بن علي÷ ومعاوية بن أبي سفيان عدداً من الشروط، والتي أكّدت على تسليم الأمر إلى معاوية، وعليه العمل بكتاب الله وسنّة رسوله’ وسيرة الخلفاء الصّالحين([18])، وأن يكون الأمر بعد معاوية شورى بين المسلمين، وفي رواية أخرى أن تكون الخلافة للإمام الحسن×، فإن حدث به حدث فلأخيه الإمام الحسين×، وليس لمعاوية أن يعهد بالخلافة إلى أحد([19])، وأن يترك شتم الإمام علي بن أبي طالب× على المنابر، وأن لا يُذكر إلّا بخير([20])، ويُستثنى ما موجود في بيت مال الكوفة ومقداره خمسة ملايين من تسليمه إلى معاوية، وعلى معاوية أن يجعل للإمام الحسن× كلّ عام مليون درهم، وأن يُفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وأن يفرّق في أولاد مَن قُتِل مع الإمام علي بن أبي طالب× يوم الجمل سنة 36هـ/656م([21]) ويوم صفين سنة 37هـ/657م([22]) مليون درهم، ويكون ذلك من خراج دار ابجرد([23])، ويكون النّاس آمنين حيث كانوا في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وأن يأمن الأسود والأحمر، وأن لا يأخذ معاوية النّاس بهفواتهم وماضيهم، وأصحاب الإمام علي بن أبي طالب× وشيعته في أمان حيث كانوا، ولا ينالهم بمكروه، وإنّهم آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، ولا يتعقّب أو يتعرّض لأحد منهم بسوء، ويوصل لكلّ ذي حقّ حقّه، ولا يبغي للإمام الحسن والحسين وآل بيت الرسول^ غائلة، سرّاً أو جهراً، في أيّ أفق من الآفاق([24]).
يُلاحظ ممّا تقدّم أنَّ شروط الصلح كان هدفها: بناء مجتمع إسلامي تسوده الأخوة والمحبّة والعدالة والمساواة بلا ضغائن وكراهية، يعيش فيه الفرد بأمان على عقيدته الإسلامية وأفراد أسرته وممتلكاته وأمواله، وأن تُحترم المقدّسات، وأن يُراعى آل بيت النبوّة بما يستحقّونه وفقاً لما جاء في كلّ من القرآن العظيم والسنّة النبوية الشريفة، ويُوضع الحقّ ـ في كلّ الأمور ـ في نصابه الصحيح، ويأخذ كلّ ذي حقّ حقّه دون تفريق أو تفضيل صلة قرابة. ولكنَّ معاوية بن أبي سفيان لم يلتزم بتلك الشروط، بل تنصّل عنها، وقبل رجوعه إلى الشام مقرّ حكمه ومن على منبر الكوفة خاطب أهلها مبيناً ذلك بقوله: «إنّي منيت الحسن، وأعطيته أشياء، جعلتها تحت قدمي، لا أفي بشيء منها»([25])، وأضاف: «إنّي والله ما قاتلتكم لتصلّوا، ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتزكّوا، إنّكم لتفعلون ذلك، وإنّما قاتلتكم لأتأمّر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم كارهون»([26]).
وعند انصـراف معاوية بن أبي سفيان إلى الشام
ولّى على الكوفة المغيرة
بن شعبة([27]) (41ـ50هـ/662ـ670م)، والذي بدأ
بضـرب الخوارج بالشيعة؛ لإضعاف الطرفين والتخلّص منهما، أو لإشغالهم في ما بينهم،
فأرسل ثلاثة آلاف مقاتل من أهل الكوفة لمقاتلة الخوارج الذين ثاروا ضد الحكم
الأموي([28]).
وشَنَّ معاوية بن أبي سفيان حملة واسعة لينتقم من زعماء وقادة الشيعة، وشدّد الضغط عليهم في الأمصار الإسلامية، ووجّه عماله في تلك الأمصار بأن يُعاقَب كلّ مَن يُحب الإمام عليا×وأهلبيته بمسح اسمه من الديوان، أي حرمانه من العطاء، وأن لا تقبل منه شهادة، وأن يقتل ولو بالشبهة أو بالتهمة([29]).
ومن جرّاء هذه السياسة الأموية الجائرة صار النّاس يفضلون أنْ يُقال لأحدهم زنديق([30]) أو كافر، ولا يُقال عنه من شيعة الإمام علي×([31])، ولا سيما في الكوفة، لكثرة مَن بها من الشيعة، والتي ضُمّت في سنة 50هـ/670م إلى زياد ابن أبيه عند توليته البصرة (45ـ53هـ/665ـ672م)([32])، ليكون والياً على العراق كلّه، والذي بدأ بدوره بتتبع الشيعة، وأخذ بقتلهم تحت كلّ حجر ومدر، وقطع الأيدي والأرجل وسمل العيون، وصلبهم على جذوع النخيل، وأخاف قسماً آخر منهم وأجلاهم وشرّدهم حتى نزحوا عن العراق([33]).
ومن بين المشهورين الذين تمّ قتلهم لتشيّعهم: حُجْر بن عدي الكندي([34]) سنة 51هـ/671م، ودُفن ومعه عدد آخر في مرج عذراء([35])، وعمرو بن الحمق الخزاعي([36])سنة51هـ/671م، كما تمّ قتل مجموعة أخرى لا يتّسع المقام لذكرها([37]). كما أكّد الإمام الحسين بن علي÷على مخالفة السنة النبوية من قِبَل معاوية باستلحاقه زياد بن سمية بآل أبي سفيان، زياد الذي كانت سيرته قاسية مع الحضرميين([38])؛ لأنّهم على مذهب الإمام علي×وموالين له، حيث قتلهم ومثّلَ بهم وبأمر من معاوية نفسه، علماً أنَّ دين الإمام علي×هو دين النبي محمّد’ الذي ضرب عليه آل أبي سفيان، وأجلس معاوية حيث جلس([39]). وهذا الاستلحاق أدّى إلى طعن النّاس على زياد، وأكثروا من ذلك على معاوية([40]).
لم يلتزم معاوية بن أبي سفيان بإيقاف شتم الإمام علي بن أبي طالب× من على المنابر، بل بقيَ الشتم طوال حكم بني أميّة حتى أمر بإيقافه عمر بن عبد العزيز (99ـ101هـ/717ـ719م)([41]).
ومن المؤسف أنَّ هناك مَن يبرّر شتم الأمويين للإمام علي بن أبي طالب×، إذ أشار أحد الباحثين المحدثين ـ وهو أحمد شلبي ـ إلى أنّ هذا الشتم إنْ كان معيبا فإنّه لا يقلّل من شأن معاوية وغيره من الأمويين، ولا يحطّ من قدرهم كقادة وساسة مبرزين، فإن الأمويين قد اضطرّوا إلى ذلك اضطراراً ليصرفوا النّاس عن تعلّقهم بآل البيت، وذلك لحماية دولتهم([42]).
نعم إنَّ الأمويين قادة وساسة ابتليت بهم الأمّة الإسلامية، لجورهم وفسقهم، ولكن هل الشتم يبعد النّاس عن أهل البيت؟ الذين وصّى القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة بحبهم وطاعتهم، وأكّد هذا الأمر قول الأحنف بن قيس التميمي([43]) لمعاوية بن أبي سفيان، عندما استشاره الأخير بخصوص ولاية العهد ليزيد: «وأنّك تعلم أنَّ أهل العراق، ما أحبّوك منذ أبغضوك، ولا أبغضوا علياً وحسناً منذ أحبوهما... »([44]) فلم يأتِ الشتم بثماره، وهذا التاريخ بين أيدينا وحقائقه واضحة جليّة لدى المنصفين والمحايدين، فماذا يقول في آل البيت؟ وماذا يقول في آل أميّة؟
ولم يكتفِ معاوية بن أبي سفيان بتنصّله عن الشروط آنفة الذكر، بل تخلّص من الحسن بن علي÷لإنهاء كلّ شروط الصلح. وقد قام بتكليف واليه على المدينة مروان بن الحكم([45]) بإقناع زوجة الإمام الحسن×، وهي جعدة بنت الأشعث بن قيس([46]) بسقي زوجها السمّ ليموت، ومن ثمّ سوف يزوّجها من ولده يزيد مع إعطائها مائة ألف درهم، وقد نجح معاوية في ذلك، واستشهد الإمام الحسن بن علي÷سنة 50هـ/670م([47])، ومنذ هذا الوقت بدأ معاوية بن أبي سفيان يعلن عمّا في سريرته بتولّية ابنه يزيد ولاية العهد، ومن ثمّ الحكم بعد وفاته([48]). وهذا يعني تنصّله عن شرط أن تكون الخلافة بعده شورى بين المسلمين، أو للإمام الحسين× إن حدث حادث لأخيه الإمام الحسن×([49]).
لم يكن الإمام الحسين بن علي÷ بغافل عن مجريات الأحداث التي كانت سائدة في المجتمع الإسلامي، لأن وجوه القوم ومن مختلف الجماعات تطالبه بالثورة على بني أميّة من خلال رسائلها أو وفودها عليه، سراً وعلانيةً، ومع خشيتها من أعوان بني أميّة وعيونهم([50])، إلّا أنّ الإمام الحسين بن علي÷ كان يرى النهوض والثورة على بني أميّة في ولاية معاوية أمراً عديم الفائدة في ظل الأوضاع والظروف السائدة آنذاك؛ لأنّ معاوية بما يملك من وسائل إعلامية مضلّلة واستخبارية وعسكرية، لا بدّ من أن يقضي على الثورة، ويُخرجها من اطارها الإسلامي، ولهذا كان الإمام الحسين× يوصي أتباعه بالانتظار إلى ما بعد وفاة معاوية، وعند ذلك سيكون حديث آخر([51])، إلّا أن ازدياد وفود أتباع أهل البيت على الإمام الحسين بن علي÷ أخافت والي المدينة مروان بن الحكم، الذي بدوره أرسل رسالة إلى معاوية بيّن فيها مخاوفه من ذلك([52])، وكان ردّ معاوية إلى واليه ـ ومع مشاطرته التخوف من الإمام الحسين بن علي÷ ونشاطه ـ أن أمره بعدم التعرّض للإمام الحسين× بأيّ أذى أو مكروه معلن، والتشديد في مراقبته ورصد حركاته، وبالتالي سيكون التخلّص منه سهلاً لبعده عن قاعدته في الكوفة، فلا يكون سوى علوي قد مات حتف أنفه، وسيثير موته الأسى في قلوب أهله ومحبيه وشيعة أبيه إلى حين، ثمّ يطوي النسيان ذكراه([53]). وفي الوقت ذاته أرسل معاوية رسالة إلى الإمام الحسين× يخبره فيها علمه بما يقوم به هو وأتباعه، ويطلب منه الوفاء بالعهد، لأنّه(الإمام الحسين×) أعدل النّاس، ولا يكون سبباً في شقّ عصا هذه الأمّة ودخولها في فتنة، ويحذّره من النّاس وبلوتهم، والنظر لنفسه ودينه ولأمّة محمد’([54]).
إنّ المتمعّن في رسالة معاوية إلى الإمام الحسين× يجد فيها من المغالطات ما يجعل المنصف يقف حائراً، ويطرح تساؤلات منها : أنّ معاوية يشهد للحسين بعدالته ويطلب منه الوفاء بالعهد، وهنا يمكن القول: أين معاوية من الوفاء بالعهود التي قطعها على نفسه في صلحه مع الإمام الحسن بن علي÷؟! ويطلب معاوية من الإمام الحسين أن لا يكون سبباً في شقّ عصا هذه الأمّة وإدخالها في فتنة كبيرة، ولكن أين هو معاوية من الفتنة التي أشعلها في حربه مع الإمام علي بن أبي طالب× إبان معركة صفّين، والتي مزّقت الأمّة الإسلامية وشقّت صفّها؟! كما أنّه يُحذّر الإمام الحسين من النّاس وبلوتهم ولم يحذّر نفسه، ويوجّه النصح له في المحافظة على دينه وأمّة الإسلام.
ردّ الإمام الحسين× على رسالة معاوية بن أبي سفيان برسالة اتّصفت بالفصاحة والبلاغة، وفضحت معاوية وممارسات حكمه، وانتهاكات حقوق الأمة، قد بيّن الإمام فيها موقفه في هذه المرحلة، وأنّه لا يريد الثورة على بني أميّة، ولا يريد خلافاً معهم، مع وجوب عمل ذلك شرعاً إرضاءً لله تعالى، وإنَّ أعظم فتنة على الأمّة الإسلامية هي إمارة معاوية بن أبي سفيان عليها. ثمّ بيّن لمعاوية ناصحاً إذا أراد الكيد به، فإن الكيد كثيراً ما يتعرّض له الصالحون، وبكيدك لا تضرّ إلّا نفسك، وستمحق عملك، كما أوصاه بتقوى الله تعالى، وذكّره بكتابه الذي لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلّا أحصاها، وأنّه لا ينسى القتل بالظن والأخذ بالتهمة، وأشار الإمام الحسين× إلى معاوية بأنه أوبق نفسه، وأهلك دينه، وضيّع الرعية([55]).
إلّا أنّ ردّ الإمام، وتأكيده على قدرة أهل البيت على تحمّل مسؤولية الحكم والخلافة، والعودة إلى منهج الكتاب والسنّة؛ لم يُجدِ نفعاً لوضع الأمّة الإسلامية في طريقها الصحيح مع مَن عطّلوا الحدود، وأظهروا الفساد، وحلّلوا الحرام، وحرّموا الحلال. بل ولم ينفع ـ على أقل تقدير ـ لتنفيذ ما أُتُفِق عليه من شروط، ممّا أضطر الإمام الحسين× إلى اتباع أسلوب آخر في مواجهته لمعاوية، فتوجّه للحجّ ومعه عبد الله بن عباس وعبدالله بن جعفر، فعمد إلى جمع مواليهم من الأنصار والمهاجرين، ومَن اتبعهم من الشيعة ومَن حجّ معه من أهل بيته، وكذلك طلب أنْ يجمع له كلّ مَن حجّ من أصحاب الرسول’، الذين عُرِفوا بالتقوى والصلاح وحبهم لآل البيت، فتجمّعوا في (منى)، وقد ركّز الإمام الحسين×في هذا الاجتماع على أمور هامّة، منها:
1 ـ شجب سياسة معاوية تجاه آل البيت وشيعتهم.
2 ـ دعا المسلمين لإشاعة فضائل أهل البيت^، وإذاعة مآثرهم التي حاولت السلطة الأموية حجبها واخفائها عن المسلمين.
3ـ التمهيد لخلق قاعدة معارضة تشعر بالحاجة إلى التغيير والاصلاح([56]).
لقد حاول معاوية ـ وبالاكراه ـ أخذ البيعة ليزيد من أهل الحل والعقد، أولئك كبار الصحابة وممّن بقي منهم من المهاجرين والأنصار وأبنائهم، ممّن عُرِفوا بالتقوى والصلاح، وقد استخدم لأجل ذلك كافّة وسائل الشدّة والارهاب ضد المخالفين والمعارضين له، وفي الوقت نفسه استخدم كافّة وسائل الترغيب واغداق الأموال على مَن يبيعون ذممهم ودينهم للحكام([57]).
وتشير الروايات التاريخية إلى أنّ فكرة توليّة يزيد بن معاوية ولاية العهد كانت بمقترح من قبل المغيرة بن شعبة (41ـ50هـ/662ـ670م) والي الكوفة، الذي ثبّت ولايته على الكوفة بعد أن كان معاوية يريد عزله؛ لكبره وضعفه([58])،ففي لقاء معاوية بن أبي سفيان بالمغيرة بن شعبة حول أمر ولاية العهد طمأن الأخير الأول، وبدّد مخاوفه في تحقيق هذا الأمر، وأنّه يكفيه أهل الكوفة في حين أنّ زياد ابن أبيه يكفيه أهل البصرة، وليس بعد هذينِ المصرينِ أحد يخالف([59])، وأنّ زياد ابن أبيه لم يعارض هذا الامر، بل أجاب على رسالة معاوية بن أبي سفيان التي كان يستشيره فيها حول البيعة ليزيد طالباً موافقته. ومع ما كان يعرفه زياد من تصرفات يزيد الشائنة التي تثير النّاس إذا ما قورنت بسلوك كبار ابناء الصحابة، الا أنه نصح معاوية بأن يأمر ولده حتى يتخلق بأخلاق أولئك الرجال حولاً أو حولين عسى أن ينسى النّاس ما كان منه، وأن لا يتعجل في هذا الأمر ويتأنى لتحقيقه([60]).
لقد انسجمت موافقة ولاة أهم مصرين من أمصار دولة بني أميّة مع رغبة معاوية ابن أبي سفيان بان لا يتولى الحكم أحد من غير بيته، سواء اقترح عليه المغيرة ابن شعبة أو غيره، أو لم يقترح عليه أحد فإنه ماضٍ في تنفيذ مخططه الرامي إلى جعل الحكم في البيت الأموي. وهكذا بدأ معاوية في أخذ البيعة لابنه يزيد سنة 55هـ/674م من وفود الامصار التي قدمت إلى دمشق بعد أن رتب لقاءاً لهم معه، واتفق مع بعض المؤيدين لأخذ البيعة ليزيد بأن يتحدثوا بين وفود الأمصار عن موافقاتهم بتولية يزيد([61]). ولم يبق أمام معاوية بن أبي سفيان سوى أهل المدينة وفيها من الصحابة وأبنائهم، وعليه أن يجس نبضهم في أمر تولية ابنه يزيد ولاية العهد. وقبيل وفاة الإمام الحسن بن علي× سنة 50هـ/670م قام معاوية بن أبي سفيان بزيارة إلى المدينة، ولمّا استقرّ في بيته أرسل إلى عبد الله بن عباس([62])، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب([63])، وعبد الله بن عمر([64])، وعبد الله بن الزبير([65])، وأمر حاجبه أن لا يدخل عليهم أحدا إلى أن يخرج هؤلاء النفر، وتحدّث معهم مبيّناً لهم بأنّه قد كبر سنّهُ ووهن عظمهُ وقرب أجله، وإنّي أرىد أن أستخلف عليكم ولدي يزيد وهو أهل لذلك، وأنتم صلحاء القوم وخيارهم وأبناء خيارهم، وطلب رأيهم في هذا الأمر. ثمّ تكلّم كلّ واحد منهم وبيّن رأيه لمعاوية، ويبدو أنّ آراء العبادلة لم تكن منسجمة مع ما يريده معاوية، وبالرغم من حديثه الطويل معهم عاد إلى دمشق ولم يتمكّن من اقناعهم بأخذ البيعة منهم لابنه يزيد، ولم يقطع عنهم شيئاً من صلاتهم وأعطياتهم([66]).
وبعد وفاة الإمام الحسن بن علي× لم يلبث معاوية بن أبي سفيان إلّا قليلاً حتى أخذ البيعة لابنه يزيد في بلاد الشام سنة 51هـ/671م، ثمّ بعد ذلك كتب ببيعته إلى الأمصار، ومن بينها المدينة التي كان عامله عليها مروان بن الحكم، فطلب منه أن يأخذ البيعة من أهلها ليزيد([67]). وبعد مراسلات بين معاوية ومروان لم تأتِ بنتائج ترضي معاوية([68])، وفي حقيقة الأمر أنَّ مروان عندما قرأ رسالة معاوية الأخيرة لتوليّة يزيد الحكم بعده أنكر ذلك على معاوية، إلّا أنّ مروان قد غيّر موقفه، ووافق على البيعة عندما اشترى موقفه معاوية بألف دينار تصرف له شهرياًّ، وخصّص لأفراد عائلته عشرة آلاف دينار([69]). وكتب مروان إلى معاوية يخبره بإنكار قريش ورفضهم البيعة ليزيد. ولمّا وصل كتاب مروان إلى معاوية عزله عن ولاية المدينة، وولّى مكانه سعيد بن العاص([70])، وطلب منه أخذ البيعة من أهل المدينة ليزيد، وأن يستعمل معهم الشدّة، ويكتب له عن مَن أسرع للبيعة ومَن لم يسرع([71]). فطلب والي المدينة الجديد من أهلها مبايعة يزيد، وقد استعمل معهم الشدة والقسوة، إلّا أنّ أهل المدينة لم يجيبوه للبيعة إلّا القليل منهم، وخاصّة بنو هاشم فإنّه لم يجبه منهم أحد، أمّا ابن الزبير فقد كان من أشد المعارضين لبيعة يزيد وإنكاراً لها([72]).
عندما لم يحصل معاوية على ما أراد، سلك طريق الحرمان الاقتصادي على بني هاشم من دون النّاس؛ عقوبةً لهم لامتناعهم عن بيعة يزيد، فمنع صلاته عن الإمام الحسين× حتى ضاقت عليه حاله، فقاسمه عبيد الله بن عباس([73]) ماله، ليخفف عنه([74])، ولم تنجح محاولة معاوية بثني بني هاشم عندما منع عنهم العطاء لمدّة سنة كاملة لمبايعة يزيد، حيث لم يستسلموا له، بل ازدادوا إصرارا على رفض البيعة ليزيد وشجبهم لها. وهدد ابن عباس معاوية بن أبي سفيان بتأليب النّاس بالخروج عليه، فتراجع عن قراره في منع العطاء عنهم([75]).
ومن بين الأعمال التي اتبعها معاوية لحرمان أهل البيت من الأموال والتضييق عليهم: إعطاؤه فدكاً إلى مروان بن الحكم؛ ليُغيّب آل بيت الرسول’ ويضيّق عليهم([76])، وبقي معاوية بن أبي سفيان في الحكم حتى توفي سنة 60هـ/679م، وله من العمر 78 عاماً([77]).
ممّا تقدّم يمكن القول بأنّه بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب× على يد الخوارج، وتولّي الإمام الحسن بن علي÷ الخلافة، والذي لم يستمر فيها طويلاً؛ لتفرق اصحابه وعدم طاعتهم له؛ جعله يتنازل لمعاوية بالخلافة حقّناً للدماء، ووفقاً لشروط بينهما، تضمن من وجهة نظر الإمام الحسن× بناء مجتمع إسلامي يسوده العدل والمساواة وأمان النّاس على أنفسهم وممتلكاتهم، إلّا أنَّ معاوية كان ذا وجهة نظر أخرى، لهذا تنصّل عن جميع تلك الشروط، بل والأنكى أن قام بتدبير قتل الإمام الحسن×، وعدم ترك الحكم من بعده للشورى بين المسلمين، أو للإمام الحسين×، بل انصرف لتنفيذ ما كان يفكّر به في كيفية حفظ الحكم في أسرته لأولاده وأحفاده، وبدأ يطالب بالبيعة لولده يزيد بولاية العهد أولاً، وفي الحكم بعد مماته ثانياً، وهذا لاقى معارضة من قبل أصحاب الحلّ والعقد متمثّلةً ببعض الصحابة وأولادهم وبني هاشم، وفي مقدّمتهم سيّد هذا البيت الإمام الحسين بن علي÷، ولم يفلح معاوية في تحقيق ذلك كاملاً حتى توفّي سنة 60هـ/679م. ومع ذلك فإنّ الأمّة الإسلامية لم تتمكّن من اختيار خليفة ذي مبادئ إسلامية، بل ورّثت الخلافة لشخص هوايته اللعب مع القرود واللهو والصيد وشرب الخمر، وسبب ذلك ما تعانيه الأمّة الإسلامية من فرقة الصف، لأن جلّ تفكير أفرادها كان منصبّاً على تحقيق مصالح ذاتية؛ ولهذا كان الجو مهيّئاً ليتولّى يزيد بن معاوية الحكم.
وبعد وفاة معاوية بن أبي سفيان تسلّم ولده يزيد الحكم، وذلك في النصف من رجب سنة 60هـ/679م([78])، ولم تكن لديه الخبرة والتجارب الكافية التي تؤهّله لقيادة الأمّة الإسلامية؛ كما أنّه كان منصرفاً للهوّ والقنص والخمر والنساء وكلاب الصيد، ويتّصف بكل الصفات الرذيلة في ارتكاب الفحشاء والمنكر، وهذا ما أجمعت عليه المصادر التاريخية التي بين أيدينا([79]). وبعد أن استتبّت الأمور ليزيد بن معاوية في بلاد الشام، وأصبحت أجهزة الدولة منقادة إليه، كان أوّل ما فكّر به هو اخضاع معارضيه في المدينة، لذلك كتب إلى والي المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان([80]) يأمره بأخذ البيعة له بشدّة من كافّة النّاس، والتأكيد بشكل خاصّ على بيعة الإمام الحسين×؛ باعتباره كبير البيت الهاشمي، ويتمتّع بمكانة مرموقة بين النّاس لا يتمتّع بها شخص آخر من بين أبناء الصحابة، وكذلك من عبد الله بن الزبير؛ باعتباره من أشدّ المعارضين للبيعة، ومَن يمتنع يضرب عنقه ويرسل رأسه([81]). ومع علمه بأن هؤلاء النفر لم يستطع معاوية بن أبي سفيان أن يأخذ منهم البيعة لولده يزيد، مع ما يتمتّع به من الحيلة والدهاء والمكر، فكيف يستطيع الوليد ابن عتبة أن يحقّق ما عجز عنه معاوية؟!
فبعد أن مضى من الليل شطرٌ بعث الوليد بن عتبة إلى الإمام الحسين×؛ لعله يحصل على موافقته ولو سرّاً على البيعة ليزيد بن معاوية، وهو يعلم بأنّه إذا أعطاه ذلك لن يتراجع عن قوله أو بيعته. وعندما دخل الإمام الحسين× على الوليد بن عتبة وجد عنده مروان بن الحكم، فسأل الحسينُ× الوليدَ بن عتبة: لماذا دعوتني؟ فأجابه الوليد: دعوتك للبيعة، فقال الحسين×: إنّ مثلي لا يبايع سرّاً، ولا يجتزئ بها منّي سرّاً، فإذا خرجت إلى النّاس ودعوتهم للبيعة دعوتنا معهم، وكان الأمر واحداً. فسمح الوليد للحسين بالانصراف، إلّا أنّ مروان بن الحكم اعترض وقال: لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه على مثلها أبدا حتى تكثر القتلى بينكم وبينه، أحبسه فإن بايع والّا ضربت عنقه. فوثب الإمام الحسين× قائلاً: يا ابن الزرقاء أأنت تقتلني أم هو؟! كذبت والله ولُؤمت، ثمّ التفت× إلى الوليد وأخبره عن عزمه وتصميمه على رفض البيعة ليزيد قائلا: أيّها الأمير إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلَف الملائكة، ومحلّ الرحمة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق، شارب خمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أيّنا أحقّ بالخلافة والبيعة. ثمّ عاود مروان بن الحكم الحديث بلين مع الإمام الحسين× بشأن مبايعة يزيد، ويبدو أنه لم ييأس من ذلك قائلاً له: يا أبا عبد الله إنّي لك ناصح، فأطعني ترشد وتسدّد، فإنّي آمرك ببيعة يزيد، فإنّه خير لك في دينك ودنياك. فقال الإمام الحسين×: إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام إذ قد بُليت الأمّة براعٍ مثل يزيد([82]).
وكتب يزيد إلى الوليد بن عتبة مرّة أخرى بأن يأخذ البيعة من الإمام الحسين×، وإن امتنع فليكن جوابه ومعه رأس الحسين×، وإن فعل ذلك فله الجوائز والحظ الأوفر([83]). إلّا أنّ الوليد بن عتبة رفض ذلك بقوله: «والله ما أحب أنّ لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وأنّي قتلت حسينا، سبحان الله أقتل حسينا إن قال لا أبايع، والله إنّي لأظنُّ أنّ امرءا يحاسب بدم حسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة»([84]).
عزم الإمام الحسين× على الخروج من المدينة بعد أن أيقن بأن حياته باتت مهدّدة بالخطر من قبل الأمويين، وأن السلطة عازمة على التخلّص منه بأيّ ثمن، فأتجه إلى مكّة ليلوذ بالبيت الحرام في ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة 60هـ/679م، ليكون بمأمن من مضايقات وكيد الأمويين واعتدائهم([85])، وقد سلّم الإمام الحسين× وصيته قبل خروجه إلى مكّة لأخيه محمّد بن الحنفية، والتي وضّح فيها غايته وأهداف اعتراضه، حيث قال: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الاصلاح في أمّة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمَن قبلني بقبول الحقّ والله أولى بقبول الحقّ»([86]).
لقد وصل الإمام الحسين× إلى مكّة في اليوم الثالث من شعبان سنة 60هـ/679م([87])، وهو يتلو قوله تعالى: (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ) ([88]). لقد اتّخذ الحسين× مكّة، لما تمثّله من موقع إسلامي عام للمسلمين مقرّاً لحركته، ومن ثمّ إعلان ثورته، وذلك بعد أن بيّن للنّاس ـ الذين وفدوا على مكّة سواء للعمرة أو أداء فريضة الحج من الأمصار الإسلامية خلال الأربعة أشهر التي قضاها في مكّة قبل مغادرته إلى العراق ـ أهداف تلك الثورة، وشعارها إحياء السنّة وإماتة البدعة، وضمّ لحركته الذين يرغبون في التخلّص من سلطة بني أميّة، والسير خلف راية آل البيت ممثّلةً بالحسين×. كلّ هذا شكّل تحديّاً كبيراً أقلق السلطة الأموية وقضّ مضاجعها؛ لأنّ الإرادة الشعبية قد أبدت مطالبها، ولو ظاهرياً للإمام الحسين× بالقيام بالثورة على السلطة الغاصبة لحقوق الأمّة الإسلامية عامّة وآل البيت خاصّة، وبدا ذلك من خلال تفضيل الإمام الحسين÷ بعد اعلانه عدم البيعة ليزيد وقدومه إلى مكّة([89]).
وفي العراق علم شيعة آل البيت بوفاة معاوية، وخروج الإمام الحسين× إلى مكّة ورفضه البيعة ليزيد، فعقدت جماعة من أهل الكوفة ـ من الذين نالهم الاضطهاد والتنكيل من جرّاء السياسة الأموية الظالمة في عهد معاوية ـ اجتماعا في بيت الصحابي سليمان بن صرد الخزاعي([90])؛ ليتدارسوا الوضع الجديد، وموقفهم منه، واتّخاذ التدابير الملائمة له([91]). وعقدت جماعة أخرى من أهل البصرة اجتماعاً مماثلاً لأهل الكوفة في بيت امرأة من عبد قيس، وفيه انتقدوا سياسة معاوية بن أبي سفيان، ورفضوا مبايعة ولده يزيد، واستقرّ رأيهم على دعوة الإمام الحسين× بالقدوم عليهم، وقيادة الثورة ضد الأمويين([92]).
لقد توالت الوفود والرسائل على الإمام الحسين× في مكّة من أهالي الكوفة والبصرة؛ تحمّله المسؤولية الشرعية في قيادة الأمّة، فكان مَن قَدِم من أهل الكوفة قيس بن مسهّر الصيداوي([93]) وآخرون([94])، ومن أهل البصرة يزيد بن نبيط([95]) وآخرون([96]).
وجواباً على رسائل أهالي الكوفة والبصرة حدّد الإمام الحسين×لهم نظرته للحكم والسلطة، وصفات الإمام وحقوقه وواجباته وطاعته مادام يعمل بالكتاب والسنة، ومفهومه لإرادة النّاس وبيعة الجمهور له؛ من خلال رسالته إلى أهل الكوفة بقوله: «... لقد فهمت كلّ الذي قصصتم وذكرتم، وما قال جلّكم إنّه ليس علينا إمام، فأقبِل لعلّ الله أن يجمعنا بك على الهدى والحقّ، فلعمري ما الإمام إلّا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحقّ، والحابس نفسه على ذات الله»([97]). وجاء في رسالة الإمام الحسين× إلى أهل البصرة قوله: «... فقد بعثت رسولي بهذا الكتاب، وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنّة نبيه’، فإنّ السنّة قد أُميتت، وإنّ البدعة قد أحييت، وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله»([98]).
كان قرار الإمام الحسين× النهائي هو الثورة على الأمويين، ممّا دفعه إلى حرصه على تهيئة الموقف السياسي في العراق قبل الوصول إليه أمام إلحاح أهل العراق ورسلهم ورسائلهم له في مكّة، ولكي يطمئنّ من هذا الموقف أرسل إلى العراق رسولين، الأول إلى البصرة وهو مولاه سليمان بن رزين([99])، وصادف وصوله وهو يحمل الرسالة إلى أهل البصرة في الليلة التي يستعدّ فيها عبيد الله بن زياد([100]) والي البصرة بالتوجّه إلى الكوفة؛ ليتولّى ولايتها تنفيذاً لأوامر يزيد، وما إن عرف بمهمّة هذا الرسول حتى أمر بقتله وصلبه([101])، وأرسل الإمام الحسين× رسولاً آخر إلى الكوفة هو ابن عمّه مسلم بن عقيل بن أبي طالب×([102])، وحمّله رسالة قال فيها: «قد بعثت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي، وأمرته أن يكتب إليّ بحالكم وأمركم ورأيكم، فإن كتب إليّ أنّه قد أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت علي به رسلكم وقرأت في كتبكم، أقدم عليكم وشيكا إن شاء الله»([103]).
عند وصول مسلم بن عقيل× إلى الكوفة نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي([104])، وأقبل الشيعة عليه، وقد بايعه ثمانية عشر الفاً([105])، ثمّ قام مسلم بن عقيل× بجمع الأموال وشراء السلاح؛ من أجل إعداد الكوفة إعداداً عسكريّاً إلى حين وصول الإمام الحسين×([106])، ولم يُضيّق والي الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري (59ـ60هـ/ 679ـ680م)([107]) على نشاط الكوفيين ومسلم بن عقيل× معاً، رغم تهديداته المتواضعة في هذا الوقت([108]).
ويبدو أنّ ما كان يجري من إعداد أهل الكوفة عبر البيعة للإمام الحسين×، والتسليح والإعداد لمواجهة السلطة؛ جعل مسلم بن عقيل× يكتب إلى ابن عمّه الإمام الحسين× بالقدوم إلى الكوفة([109])، إلّا أنّ هذا الوضع لم يستمرّ طويلاً، بل اعترض بعض الموالين لبني أميّة على سياسة النعمان بن بشير الضعيفة، وطالبوه باتّباع سياسة العنف مع الأحداث المتسارعة الجارية في الكوفة، وعندما لم يسمعهم في ذلك كتبوا إلى يزيد بن معاوية يخبرونه بحاله. ولخوف الأخير من ضياع الكوفة ببقاء النعمان بن بشير والياً عليها([110])؛ عزله وولّى مكانه عبيد الله بن زياد، وأمره بقتل مسلم بن عقيل×([111]). وصل عبيد الله بن زياد إلى الكوفة ليلاً وهو يرتدي ثيابا يمانية، وعلى رأسه عمامة سوداء([112])، وظنَّ النّاس أنّه الإمام الحسين×؛ لأنّه كان مغطّياً وجهه، وقد ساء ذلك ابن زياد([113])، وحال وصوله اتّخذ إجراءات قاسية وصارمة تمكّن من خلالها أن يُشتّت شمل أصحاب مسلم بن عقيل×([114])، ومن ثمّ القبض على مسلم بن عقيل× وهانئ بن عروة([115]) وقتلهما، وإرسال رأسيّهما إلى يزيد بن معاوية([116]). وكان مقتل مسلم بن عقيل× يوم الأربعاء الثامن من ذي الحجّة سنة 60هـ/679 م([117]).
وقد حاول مسلم× قبل قتله أن يثني الإمام الحسين× من القدوم إلى الكوفة، حيث أوصى محمّد بن الأشعث([118]) أن يقوم بإخبار الإمام الحسين× بتخاذل الكوفيين ونكوصهم، وكرّر هذا الطلب مع عمر بن سعد، عندما تأكّد من أنّه سيُقتَل، إلّا أنّ الإثنين لم يلبيّا طلب مسلم×([119]).
لم يكتفِ عبيد الله بن زياد
بقتل جميع رُسُل الإمام الحسين× الذين قَدِموا
إلى العراق، بل انتقل ـ وبتوجيه من يزيد بن معاوية ـ إلى مرحلة جديدة ، وذلك
بسدّ المنافذ بوجه الإمام الحسين×؛ لمنع دخوله الكوفة أو خروج أصحابه
إليه، ولهذا الغرض وضع الحصين بن نمير([120]) صاحب
شرطته في القادسيّة([121])، ومنها
إلى خفان([122])، ومن
القادسيّة إلى القطقطانة([123])، وإلى
جبل لعلع([124]). وقد نشر
قواته في هذه المناطق([125])، وأمر
ابن زياد أيضا أن يأخذ الطريق ما بين واقصة([126]) على طريق
الشام إلى طريق البصرة، فلا يدعنَ أحداً يدخل أو يخرج([127]).
وقد استهدفت هذه الخطّة العسكرية ـ علاوة على سدّ المنافذ بوجه مَن يحاول اللحاق بالإمام الحسين× ـ منع اتصال الإمام الحسين× بالكوفيين أو وصول مبعوثيه، وهذا ما تحقّق فعلاً عندما تمكّنت هذه القوات من القبض على رسول الإمام الحسين× إلى الكوفة قيس بن مسهر الصيداوي وقتله([128]). وألقي القبض على عبد الله بن يقطر رسول الحسين إلى مسلم بن عقيل× وقتل أيضاً([129]).
وقد بثّ عبيد الله بن زياد الرعب والخوف في أوساط أهل الكوفة حتى لا يخرج أحد لنصرة الإمام الحسين×، كما قام عامدا بقتل بعض الشخصيات الشيعية ليكون رادعاً لغيرهم، أمثال رشيد الهجري([130])، وهو من كبار صحابة الإمام علي بن أبي طالب×([131])، وكذلك ميثم بن يحيى التمّار الأسدي([132])، والذي صلبه ابن زياد عاشر عشرة في الكوفة، ولم يمنعه ذلك من التحدّث في فضائل بني هاشم، فقيل لابن زياد لقد فضحكم هذا العبد، فأمر بلجمه، ثمّ طُعِن بحربة بعد ثلاثة أيّام من صلبه، وكان ذلك قبل قدوم الإمام الحسين× إلى العراق بعشرة أيام([133]).
عندما عزم الحسين× على الخروج إلى العراق كان قد اصطحب معه أهل بيته وأبناء عمومته، وكلّهم من آل أبي طالب فحسب، وضمّ إليه مَن اصطحبه من الأنصار، ومّن تبعه من أهل الحجاز والكوفيين والبصريين، ومَن جاء موفوداً أو رسولاً فعاد مصاحباً وملازماً([134]). كان انتقال الإمام الحسين بن علي÷ من المدينة المنوّرة إلى مكّة المكرّمة هدفه الاحتماء بالبيت الحرام، لكن هذا لم يدم طويلاً؛ لأنّه كان يخشى استهداف بني أميّة لشخصه، وأنّهم يتعقبونه في كلّ مكان وأين ما يكون، فهو ميت مقتول على أيّ حال، سواء بقي في مكّة أم خرج منها، فإنّ بني أميّة قد صمّموا على تصفيته ولو كان متعلّقاً بأستار الكعبة، وكان الإمام الحسين× حريصاً على أن لا تُنتهك حُرمة الحرم الشريف بسفك الدماء فيه([135])، والسلطة الأموية في هذا الوقت لم تترك الإمام الحسين× دون انتزاع البيعة منه أو قتله.
لقد صرّح الإمام الحسين× بهذه الحقيقة في كلامه مع الذين حاولوا أن يثنوه عن مسيره إلى العراق، وخروجه من مكّة بقوله: «... والله لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلّط الله عليهم مَن يذلّهم... »([136])، وفي قول آخر للإمام الحسين×: «... وأيمِ الله لو كنتُ في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم... »([137]).
لم تتوقف نصائح الناصحين للإمام الحسين× بثنيه من التوجّه نحو العراق، وحمل النساء معه خشيةً عليهم من غدر بني أميّة، من أمثال عبد الله بن عباس، الذي كان مُلِّحاً في ذلك، وكان الإمام الحسين× يردّه بقوله: «... أنّه جمع على المسير إلى العراق... »([138]) وأنّ شيعته طلبوا منه القدوم عليهم([139])، فأجابه ابن عباس: «إنّك لو قد خرجت فبلغ ابن زياد خروجك استنفرهم إليك، وكان الذين كتبوا إليك أشَدّ من عدوك، فإن عصيتني وأبيت إلّا الخروج إلى الكوفة فلا تُخرجنَّ نساءك ووِلدك معك، فوالله إنّي لخائف أن تُقتل كما قُتِل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه»([140]).
وعندما خرج محمّد بن الحنفية يشيّعه عند توجّهه إلى العراق قال له عند الوداع: «الله الله يا أبا عبد الله في حُرم رسول الله، فقال له ×: أبى الله إلّا أن يكنّ سبايا»([141]).
وكانت أمّ سلمة([142]) خائفة على الإمام الحسين×من خروجه إلى كربلاء فوضّح الإمام× لها سبب حمله النساء والأطفال معه إلى كربلاء بقوله: «يا أمّاه قد شاء اللهأن يراني مقتولا مذبوحا ظلما وعدوانا، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشرّدين، وأطفالي مذبوحين مظلومين، مأسورين مقيّدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا ولا معينا»([143]).
ولعلّ هدف الإمام الحسين×من حمله للنساء معه كان أبعد ممّا ذكره في حديثه مع أمّ سلمة، فكيف نفهم ملامح الحكمة في هذه المشيئة الإلهية وهذا الأمر النبوي وفي مخافة الإمام× على ودائع النبوة، وبالتالي إصراره على خروجهنّ معه؟
أشار أحد الباحثين إلى أنّ الإمام الحسين× لو ترك النساء فلا يبْعُد أن تقوم السلطة الأموية بالقبض عليهن وزجّهنَّ في السجون، وحينما يحدث ذلك فلا شك أنّه سيؤثّر على النهضة الحسينية ومساراتها، حيث لم يكن حينها أمامه إلّا الاستسلام لإنقاذ الأهل والحرائر، وحينها تقع المخالفة الصّريحة مع نهضة الإصلاح التي أعلنها الإمام الحسين× وسعى من أجلها، أو يكون الخيار هو المضي في النهضة وترْك المخدّرات في حالهن المزري المحتمل، وهذا أمر لا يمكن أن يتحمّله الحسين×؛ لعزّة نفسه وغيرته على أهله، لما يعرفه عن بني أميّة من عدم مراعاتهم لأيّ حرمة، أو التزامهم بأيّ خُلُق عربي أو إسلامي من أجل تحقيق غايتهم، فلا يبعد أن يقوم بنو أميّة باعتقالهنّ وزجهنَّ بالسجن، مادام ذلك يخدم مقاصدها وأهدافها في القضاء على النهضة الحسينية وإيقاف مسيرتها، حيث سجّل لنا التاريخ مشاهد مروّعة في هذا الاتجاه، فقد سجنوا زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي([144])، كذلك ما قامت به السلطة الأموية في واقعة الحرّة من انتهاك حرمات الأعراض واستباحتها([145])، إذ كان لا بدّ للإمام× من حمل هذه الودائع ونسائه معه؛ حتى لا يتمكّن العدو من إعاقة مسار النهضة المقدّسة([146])، فضلاً عن الأثر العظيم المترتّب على العمل الإعلامي والتبليغي الكبير، الذي سيقوم بأعبائه ممَّن تبقّى من الركب الحسيني، فما كان للثورة الحسينية أن تصل إلى تمام غايتها لو لم تكن تلك الودائع النبوية في الركب، وهذا ما سنتحدّث عنه في الفصول القادمة.
كان خروج الإمام الحسين× من مكّة يوم الثلاثاء الثامن من ذي الحجة، يوم التروية([147])، وذلك عندما جاءته رسالة من مسلم بن عقيل× أخبره فيها اجتماع الكوفيين عليه، ويدعوه بالقدوم إلى الكوفة([148]).
ولم تنجح محاولات السلطة الأموية في مكّة من منع الإمام الحسين× بالتوجّه إلى العراق([149]). وبعد فشل عمرو بن سعيد الأشدق في تنفيذ أوامر يزيد بن معاوية في منع الإمام الحسين بن علي÷ من مغادرة مكّة؛ حاول أن يثير همّة عبيد الله بن زياد في القضاء على الإمام، فكتب إليه يحذّره من أن يفوته الحسين، ويذكّره مهدّداً بعقوبة يزيد بن معاوية([150]).
لقد كان الإمام الحسين× ومنذ خروجه من مكّة وحتى وصوله إلى كربلاء، وفي كلّ مرحلة من مراحل الطريق، يعمل على تخيير مَن كان معه بالإنصراف، كما أنّه لم يتوقّف عن دعوة مَن يمرّ به لنُصرته والخروج معه، وإقامة الحجّة عليهم بالجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان يريد أن يزرع روح الثورة في نفوس النّاس ضد الحكّام الجائرين، ممّا جعل البعض يلتحق به([151]).
إنّ إعلان الإمام الحسين× ثورته على الأمويين كانت للحفاظ على الشريعة الإسلامية وتعاليمها، والحفاظ على الأمّة ومصالحها تجاه كلّ الانحرافات التي تظهر فيها، وهذا ما تفرضه المسؤولية الدينية عليه؛ باعتباره إمام الأمّة وفقاً لقول الرسول، وهو سبطه وابن ابنته، وأنّ الدين دين جدّه، والأمّة أمّة جدّه، وهو مسؤول عن رعايتهما، ومن واجباته أن يتصدّى للظلم والاضطهاد الذي حلّ بالأمّة، ولا سيما بشيعة الإمام علي بن أبي طالب× وأصحابه، ومن هنا كان عليه الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء السنّة وإماتة البدعة والجاهلية، وإعلاء راية الإسلام. وكيف لا يقوم بهذا والأمويون قد استعبدوا الأمّة، ونهبوا خيراتها من الأموال، سواء كانت من بيت المال أم من الفيء والخراج وغير ذلك.
هذا وقد خالف معاوية بن أبي سفيان كلّ الشروط التي أُبرِمت مع الإمام الحسن بن علي÷، فإنّها لو نُفِّذت لخلقت مجتمعاً إسلامياً متآلفاً، ضُمِنت فيه حقوق الأمّة وواجباتها، فكانت مخالفته قد أبعدت الأمّة عن مبادئها الإسلامية.
وخلال حكم معاوية ـ الذي استمر حوالي عشرين عاماً ـ أصاب المسلمين كثير من الظلم والجور، كما اتبع سياسة تسلّطية جعلت الخلافة ملكاً وراثياً لبني أميّة، وكان ذلك بالقهر والقوّة وشراء الذمم مع مخالفيه.
وعندما تولّى يزيد الحكم، صاحب الطرب والجواري والكلاب والقرود والفهود والمنادمة على شرب الخمور، كان أسوأ من أبيه، وبهذا فإنّ مبايعة الإمام الحسين× له تعني هدم كلّ القيم الإسلامية، فإذا سكت الحسين× وبايع يزيد فستذعن كلّ الأمّة لذلك وليقرأ عليها السلام.
لذا فإنّ هذا التخلّف الذي أصاب الأمّة الإسلامية في الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، قد دفع بالإمام الحسين× بأن يستنهض الأمّة([152])، ولا بدّ من أن يهبّ إلى ساحات الجهاد، فكان استشهاده تحوّلاً في تاريخ الإسلام وحياة الأمّة، التي لا بدّ لها أن تعيش حياةً إسلامية.
كان لموضع كربلاء الذي نزله الإمام الحسين× وأصحابه يوم عاشوراء، عدّة تسميّات، فمنهم من يرجعه إلى أنّه يعود إلى أصول عربية، بينما أشار آخرون إلى غير ذلك.
إنّ الذين أكّدوا أصل عربية كربلاء قالوا: مفردة كربلاء عربية الجذر، وتكون بالمدّ، وهو الموضع الذي قُتِل فيه الحسين بن علي ([153]) في طرف البرية عند الكوفة. وأما اشتقاقها فالكربلة: رخاوة في القدمين، فيقال: جاء يمشي مكربلاً([154])، أي كأنّه يمشي في طين([155])، ولهذا يُحتمل أن تكون أرض هذا الموضع رخوة، ويُقال: كربلة الحنطة، إذا هذبت ونقيت من القصل، أي: غربلت([156])، وربما تكون هذه الأرض خالية من الحصى والدغل فسمّيت بذلك. والكربل: اسم نبات الحماض، له نور أحمر مشرق، وربما كان هذا النوع من النبات يكثر نبته في هذا الموضع فسُمّي به([157]).
كما ذهب البعض إلى أنّ المفردة غير عربية، من قبيل ما ذكره الشهرستاني من أنّ كربلاء منحوتة من كلمتي (كور بابل)، أي أنّها مجموعة قرى بابلية([158]). وذهب آخرون إلى أنّ الكلمة فارسية المصدر، فهي مركبة من كلمتين هما: كار وبابلا، ومعناه العمل الأعلى، أي العمل السماوي محل العبادة والصلاة([159])، وأشار أنستاس الكرملي أنّ كربلاء منحوتة من كلمتين (كرب) و(إل)، أي حرم الله أو مقدس الله([160]).
إنّ كربلاء كانت من أمّهات مدن ما بين النهرين الواقعة على ضفاف نهر(بالاكوباس) (الفرات القديم)، وعلى أرضها كان معبد للعبادة والصلاة، وقد كثرت حولها المقابر، كما عثر على جثث الموتى داخل أوان خزفية يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، كما أنّها كانت موجودة قبل الفتح العربي الإسلامي للعراق، ([161]) فقد ذكرها بعض العرب الذين رافقوا القائد العربي خالد بن الوليد([162]) لفتحه غرب العراق سنة 12هـ/634م([163]).
ومهما كان من آراء المؤرخين، تبقى كربلاء الأرض المباركة التي كرّمها الله تعالى، لأنّها ضمّت بين جنباتها الجسد الطاهر لريحانة رسول الله، وامتزجت تربتها مع دماء العترة الطاهرة من آل الرسول’ الكريم وأنصارهم.
لقد أخبر الرسول’ بتسميّة كربلاء عن طريق الوحي، و هي ربما أبعد ممّا ذكره المحلّلون لهذه اللفظة، فقد أعطى الرسول’ تفسيراً واقعياً للفظة كربلاء، يُذكر أنّ فاطمة‘ كانت تحمل ولدها الحسين×، وبعد أن أخذه منها الرسول’ وذكر ما يصيبه قالت له: «يا أبه أيّ شيء تقول؟ قال: يا ابنتاه ذكرت ما يصيبه بعدي وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي، وهو يومئذ في عصبة كأنّهم نجم في السماء يتهاوى إلى القتل، وكأنّي أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع رحالهم وتربتهم قالت: يا أبه أين هذا الموضع الذي تصف؟ قال: موضع يقال له كربلاء، وهي دار كرب وبلاء»([164]).
لقد أُطلِقت على كربلاء العديد من التسميّات، ويمكن حصر أهمّها:
1ـ الطفّ: (طاء مفتوحة وفاء مشدّدة)، وهي من المواضع التي عرفها العرب قديماً بالقرب من كربلاء، وفي اللغة: ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق([165])، وهي أرض بادية قريبة من الريف، فيها عدّة عيون جارية، منها: الصيد والقطقطانة والرهيمة وعين جمل([166]).
2ـ نينوى: (كسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو)، وهي قرية يونس بن متّى بالموصل، وفي سواد الكوفة ناحية يقال لها: نينوى، منها كربلاء التي قُتِل فيها الحسين بن علي([167])، وهي قرية عامرة في العصور الماضية، وتقع شمال شرق كربلاء، وهي الآن سلسلة تلول أثرية، ممتدّة من جنوب سدّة الهندية حتى مصبّ نهر العلقمي في الأهوار، وتُعرف بتلول نينوى، وهي من المواضع التي نزلها الإمام الحسين× عند وصوله العراق([168]).
3ـ الغاضرية: وهي قرية من نواحي الكوفة، قريبة من كربلاء، وتُنسب إلى غاضرة من بني أسد([169]). ويبدو أنّ الغاضرية ليست قديمة، فهي أُنشِئت بعد انتقال قبيلة بني أسد إلى العراق في صدر الإسلام، وهي أرض منبسطة، وتقع اليوم في الشمال الشرقي من شريعة الإمام جعفر الصادق×على العلقمي بأمتار، وتُعرف بأراضي الحسينية([170]). وعن الإمام أبي جعفر الباقر قال: الغاضرية هي البقعة التي كلّم الله فيها موسى بن عمران، ونجّي نوحا فيها، وهي أكرم أرض الله، ولولا ذلك ما أستودع أولياءه وأنبياءه فيها، زوروا قبورنا بالغاضرية([171]).
4ـ النواويس: تأتي بمعنى القبر، وكانت مقبرة عامّة للنصارى قبل الفتح العربي الإسلامي، وتقع في أراضي ناحية الحسينية شمال شرق كربلاء قرب نينوى([172]). وقد ذكر الإمام الحسين× هذا الموضع في خطبته التي ألقاها في مكّة قائلاً: «كأنّي بأوصالي تقطّعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلاء»([173]).
5ـ الحائر: هو قبر الإمام الحسين بن علي÷، وتُلفظ: الحاير، وهو في الأصل حوض يصبّ إليه مسيل الماء من الأمطار، وقد سمّي بذلك لأن الماء يتحيّر فيه، يرجع من أقصاه إلى أدناه([174]). ويُقال للموضع الوسط المطمئن المرتفع الحروف حائر، وجمعه: حوران. وأكثر النّاس يسمّون الحائر الحير يستحسنون التخفيف([175])، وذكر ابن منظور: وحار الماء فهو حائر، تحيّر تردد([176])، والحائر الأرض المنخفضة التي تضمّ قبر الحسين بن علي إلى رواق بقعته الشريفة، وقد حار الماء حولها عندما أراد المتوكل العباسي(232ـ247هـ/846ـ861م) في سنة 236هـ/850م إزالة القبر وإغراقه بالماء([177]).
6ـ شطّ الفرات: وهي من التسميّات التي أُطلِقت على أرض كربلاء، وأنّ الإمام الحسين×سيُقتل فيها، ولمّا توجّه الإمام علي بن أبي طالب إلى صفِّين، مرّ على نينوى وقف فيها ونادى: «اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات»([178])، وعندما سُئل عن ذلك وضّح بقوله: «دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان، قلت: يا نبيَّ الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان! قال: بل قام من عندي جبريل، فحدّثني أنّ الحسين يُقتل بشطِّ الفرات»([179]).
7ـ ظهر الكوفة: وهي من التسميّات التي وردت عن الإمام علي بن أبي طالب× عن هذا الموضع؛ إذ قال: «بأبي وأمّي الحسين المقتول بظهر الكوفة، والله كأنّي أنظر إلى الوحوش مادّة أعناقها على قبره، من أنواع الوحوش، يبكونه ويرثونه ليلاً حتى الصباح»([180]).
8ـ عمورا: وهي ممّا ذكرها الإمام الحسين×، حيث قال: «قال لي رسول الله: يا بني إنّك تُساق إلى العراق، وهي أرض التقى بها النبيّون وأوصياء النبيّين، وهي أرض تُدعى عمورا، وأنّك ستستُشهد معك جماعة من أصحابك»([181]).
كما أطلق بعض المؤرِّخين المحدثين أسماءً على كربلاء؛ أمثال عين تمر، قصر مقاتل، شثاثا، ونهر العلقمي([182]). ومن الجدير ذكره أنّ هذه الأماكن توجد ضمن التخطيط الإداري لمحافظة كربلاء المقدّسة في الوقت الحاضر، إلّا أنها لم تكن اسماءاً للموضع الذي ارتكب الأمويون فيه جريمة قتل الحسين× وأهل بيته وأصحابه.
وبعد أن اندلعت المعركة واشتدت بين أصحاب الإمام الحسين× وجيش ابن سعد أخذ أصحاب الإمام الحسين× يستشهدون الواحد تلو الآخر، وكلمّا يصرع أحد يوصي الذي من بعده بالدفاع عن الإمام الحسين× والموت دونه، فكانوا يتنافسون في ذلك بين يديه حتى قتل أصحابه عن آخرهم([183]). وبعد ذلك برز بنو هاشمحتى نالوا الشهادة([184])، وظلّ الإمام الحسين× وحيداً يناجز الجيش الأموي، إلى أن حمل الجند ومالوا عليه من كلّ جانب رمياً بالسهام وطعناً بالرماح وضرباً بالسيوف، فقال سنان بن أنس النخعي([185]) ـ بعد أن سقط الإمام الحسين× على الأرض ـ لخولّي بن يزيد الاصبحي([186]): احتزّ رأسه، وأراد أن يفعل فضعُف وأُرعِد، فقال سنان: فتّ الله عضديك وأبان يديك، فنزل إلى الإمام الحسين× فذبحه، واحتزّ رأسه وسلمه لخولّي، وسلب ما كان عليه([187]).
لقد مارس الجيش الأموي أقصى أنواع القسوّة مع الإمام الحسين وأهل بيته^، فلمّا علا بكاء النساء وصياحهنَّ عند علمهنَّ بمقتل الإمام الحسين× أمر ابن سعد بتقويض المضارب، وحرق الخيام التي لم يبق فيها إلّا النساء والأطفال([188]).
وانتهب الجند بعد إحاطتهم بالخيام والدخول إليها قبل حرقها متاع الإمام الحسين× وثقله، فكانت المرأة تُنازع عن ثوبها حتى يُؤخذ عنها([189]).
لقد اختلف المؤرِّخون في تحديد مَن احتزّ رأس الحسين فقيل: إنه خولّي بن يزيد الاصبحي([190])، وقيل: شبل بن يزيد الاصبحي أخو خولّي([191])، وقيل: سنان بن أنس النخعي([192])، وقيل: الشمر بن ذي الجوشن([193]) وهو المشهور([194])، وأيّاً كان منهم فإنّهم جميعاً شاركوا في قتله وأهل بيته وأصحابه، إمّا بسهم أو بطعنة رمح أو بضربة سيف. ألم يكن الشمر على مدار المعركة صوّالاً وجوّالاً قاسياً جبّاراً، يحاول حرق فسطاط الإمام الحسين على أهله^([195])؟! كذلك عمر بن سعد ألم ينفّذ أمر عبيد الله ابن زياد، فاختار عشرة من أفراد جيشه ليسحقوا جسد الإمام الحسين× ويرضّوا صدره وظهره([196])؟!
وهكذا قُتل الإمام الحسين×، وعدد من بني هاشم من آل بيته، وعدد من أنصاره، فقد أُريد من هذه المعركة القضاء على هذا البيت بالكامل، إذ سُجِّلت جريمة لا تُغتفر على مرِّ العصور، ويمكن القول من أنّه لا تتكرر مثيلتها في التاريخ. ومع ذلك لم يكتفِ الأمويون بذلك، ففي اليوم التالي من يوم المعركة ساقوا عائلة الإمام الحسين×، ممَّن بقي منهم من الأطفال والنساء سبايا والرجال المرضى أسارى، وطافوا بهم مدن وقرى كربلاء والكوفة والشام، وهذا ما سنتحدث عنه في الفصول القادمة.
الفصل الاول
سبي آل البيت^ من الطفّ إلى الكوفة
المبحث الأول: معنى السبي لغةً واصطلاحاً
المبحث الثاني: مفهوم آل البيت^
المبحث الثالث: بدء السبي والوصول إلى الكوفة
الفصل الأول: سبي آل البيت^ من الطفّ إلى الكوفة
لم يكتفِ الأمويون يوم عاشوراء في العاشر من محرّم سنة 61هـ ـ الموافق للعاشر من تشرين الأول 680م ـ بارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية، وذلك بقتلهم الإمام الحسين بن علي÷ وآل بيته من أبنائه وإخوته وأبنائهم وأبناء عمومته أولاد عقيل وجعفر، فضلاً عن أنصاره من غير الهاشميين؛ بل قاموا بسبي أهله وأهل أنصاره.
قبل أن نتناول كيفية سبي آل البيت من أرض المعركة بعد ظهر يوم الحادي عشر من المحرم متوجّهين بهم إلى الكوفة([197])، لا بدّ أن نتطرّق أولاً إلى معنى السبي لغةً واصطلاحاً، وجذوره التاريخية عند الأمم المجاورة للعرب، والكيفية التي كانت عليها ظاهرة السبي عند العرب قبل الإسلام وأثناءه، وهل يحلُّ سبي نساء المسلمين وأسر رجالهم، ولا سيما آل بيت الرسول’؟! فقد اتصف تعامل الرسول’ بالرحمة والحسنى مع سبايا المشركين والقبائل الأخرى التي أعلنت عداءها للإسلام والمسلمين([198]).
وردت كلمة السبي لتدلّ على عدّة معانٍ، وقد أشار إليها علماء اللغة وبيّنوا معناها: سبّى: بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، مقصور، على وزن فعلى: رملة، معروفة بديار غطفان، وهذا لا علاقة له بما نحن فيه. والسبي: نهب وأخذ النّاس عبيداً وإماءً([199])، والسبية: المرأة المنهوبة([200])، ويقال للغلام: سبيّ، ومسبيّ، وللجارية: سبيّة، ومسبيّة، وجمعها سبايا([201])، وتسابى القوم، سبى بعضهم بعضاً([202])، ويُقال: هؤلاء سبيٌ كثير وقد سبيتهم سبياً([203]).
والسبي يقع على النساء خاصّة([204])؛ لأنّهنَّ يسبين فيُملَكن، ولا يُقال ذلك للرجال([205])، ويُقال: سبى، والسبي، وسبا هو الأسر([206]).
وقد استُعملت كلمة الأسارى مقابل السبايا، والسبي أعمّ مورداً من الأسير؛ لصدقه على أخذ مَن لا يحتاج إلى قوّة كالنساء([207]). وقد استعمل في القرآن الكريم، المعنى الأول دون الثاني، أي الأسر بدل السبي، قال تعالى: (...فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا)([208])، وقال سبحانه: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ... )([209]).
يُطلق مصطلح السبي على النساء اللائي يتعرضنَ للنهب من قبل قبيلة مهاجمة لحيهنَّ، مستغلين انشغال رجال قبيلتهن في حرب مع قبيلة أخرى بعيدة عن مضاربهم([210])، أو قد يكون مباشرةً من قبل القبيلة الغالبة على القبيلة المغلوبة([211]). وعادةً ما يكون السبي سهلاً؛ لأنّه يقع على النساء([212]) المجرّدات من السلاح اللائي سقط عنهنَّ القتال([213]).
ويُطلق مصطلح الأسر على الرجال المقاتلين في ساحة المعركة بعد وقوعهم في أيدي أعدائهم الذين غلبوهم.
ويصبح النساء والرجال عند وقوعهم في السبي والأسر عبيداً لأسيادهم([214])، ويسّخرونهم لخدمتهم كيفما يشاؤون([215]).
ويُطلق عليهم الرقيق أو الرقّ([216])، والرِقّ في اللغة: هو الملك والعبودية([217]) ورق صار رقّاً واسترقه فهو مرقوق، ومرق ورقيق، وجمع الرقيق أرقاء([218]). والرقيق من الألفاظ التي تُقال للواحد والجمع. والعبد: رقيق، والعبيد: رقيق أيضا. والرقّ يُمثّل الخضوع والطاعة، والإسترقاء هو الإدخال في حالة الرقّ، وهي حالة تملّكه وصيرورته عبداً لسبب مامن أسباب الإسترقاق المختلفة، وبذلك يُحرَم الإنسان من حريته ويكون ملكاً لغيره، ويحوّل إلى ما يشبه المتاع الخاصّ لسيّده، ويُقال في الانتقاص من كرامته، إذ إنّ الحقّ لسيّده في بيعه أو إيجاره لِمَن يشاء([219]).
والرّقّ عند فقهاء الإسلام عبارة عن حكم شرعي([220])، حيث يكون جزاء على بقاء الإنسان على الكفر([221])، ومع ذلك فإنّ الإسلام عدَّ الرقّ حالة مؤقتة وطارئة في حياة الإنسان، وأنّها ليست طبيعية؛ لأنّ الأصل هو الحرية والمساواة بين البشر، وانفرد الإسلام بإيجاد الطرق العملية للقضاء على الرقّ وتجفيف منابعه، أو حصره في مجال ضيّق؛ لكي يتمّ الإجهاز على هذه الظاهرة البغيضة إلى الأبد([222]).
وممّا تقدّم يمكن القول أنّ مفردات الأسير والعبد والرقّ والرقيق تُطلق على الرجال الذين يقعون في الأسر، ومفردات السبي والجارية والإماء والرقّ والرقيق تُطلق على النساء اللواتي يقعنَ في الأسر، أو عند شراء الرجل أو المرأة على السواء.
ومن الجدير بالإشارة إليه هنا أنّ مصطلح السبي في الوسط الشعبي المتداول بين النّاس منذ وقت ليس بالقصير، ولاسيما في العراق؛ يُطلق على الرجال والنساء الذين سُبُوا وأُسِروا من آل البيت^بعد معركة الطفّ، فيُقال عن اليوم الذي رجع ما تبقّى من عائلة الإمام الحسين×من بلاد الشام إلى العراق بعد انتهاء مدّة السبي لهم ـ وهم نساء كثر ورجال قليل ـ يوم السبايا، أو مردّ الرؤوس، أو الأربعين.
ثالثاً: الجذ ور التاريخية للسبي
إنّ الإحاطة بتاريخ السبي أمر ليس بالسهل، وقبل الخوض فيه لا بدّ من استعراض الكيفية التي كان فيها السبي قبل الإسلام بشكل موجز، فيجب الوقوف عند هذه الظاهرة الاجتماعية ومحيطها الذي ظهرت فيه، وانعكاساته على الإنسان العربي في مجتمعه. والغرض من ذلك هو معرفة حال السبايا وطرق معاملتهم، والكيفية التي تمّ فيها سبيهم لدى الأمم الأخرى المجاورة للعرب، والتي يرتبطون معها بعلاقات شتّى، ولم يتمكّن العرب المسلمون التخلّص من ظاهرة السبي حتى في ظل الإسلام.
كان السبي يحدث جرّاء الحروب التي تحدث بين الجماعات أو الأقوام لأسباب مختلفة، وشعار الحرب يومئذ سبيٌ للمغلوب، فللغالب أن يستولي على أرض المغلوب، ويغنم أمواله، ويقتل ويأسر مَن يشاء من الأفراد مثل النساء والوِلدان، وله أن يصالح المغلوب أو يكتفي بفرض الجزية عليه([223]). ثمّ أخذ الغالب في الاستفادة من السبايا والأسرى لتشغيلهم خَدَماً في البيوت، وفي الزراعة ورعي الماشية، أو في صناعة الشباك التي تستخدم للصيد، وهنا حلّ إستخدام الأسير في تلك الأعمال محلّ قتله([224]). ويُعدّ هذا الأمر تقدّماً أخلاقياً عظيماً حين أقلع عن قتل الأسير؛ إذ إنّ الأسير هنا إكتفى عدوه باسترقاقه([225]). ومع أنّ عيش الرقّ في أدنى مراتب الحياة إلّا أنّه أهون وأفضل من القتل الذي كان يتّبعه الغالب مع المغلوب([226]).
إنّ الحروب يشعل فتيلها اتفه الأسباب، وقد كانت سبباً في بادئ الأمر لظهور السبي، ومن ثمّ تحولّهم إلى الرقّ؛ إذ عرفوا قيمة الأسرى، فأخذوا يسترقّونهم ويتاجرون بهم في الأسواق، حيث نشأت وراجت أسواق النخاسة([227]) في كثير من بلدان العالم، وكان النخّاسون فيها يبيعون السبايا الذين كانوا يحصلون عليهم من خلال مرافقتهم للجيوش، إذ لم يكن همّهم التصدّي للعدو، وإنّما من أجل الحصول على السبايا الذين سيقعون أسرى بأيدي الجيوش المنتصرة([228]).
ثمّ ازدادت الحاجة إلى العبيد من الأسرى والسبايا من النساء لتلبية متطلّباتهم، ولم تكن الحروب كافية لسدّ تلك المتطلّبات، ممّا دفع إلى ظهور مصادر جديدة غير الحروب للسبي والحصول على الرجال والنساء لاسترقاقهم، كالقيام بعمليات الخطف أو الشراء، فتألّفت عصابات في البر والبحر تقوم بالإغارة على القوافل البرية، أو المراكب البحرية التي تحمل المسافرين، أو تغير على جماعة آمنة فتأسر الرجال وتسبي النساء والأطفال، وتسوقهم إلى مدن بعيدة، يُباعون فيها ويُصبحون رقّاً بعد أن كانوا أحراراً([229]).
كانت عادة الرومان القدماء إستعباد الأسرى وتحويلهم إلى رقيق. وفي البداية لمّا كان عدد الأرقاء قليلا جعل سادتهم يحسنون معاملتهم ويعدّونهم أعضاء ذوي نفع كبير، ثمّ بدأت روما في القرن السادس للميلاد عمليات الغزو والتوسّع للسيطرة على الدول المجاورة لها، ممّا أدّى إلى وقوع أعداد كبيرة من الأسرى بأيديهم بعد انتصاراتهم في المعارك التي جرتْ مع تلك الدول([230])، وانحطّتْ بعد ذلك منزلة الرقيق.
وكانت قوانين الروم تبيح معاملة العبيد كما يعامل الإنسان متاعه؛ لأنّهم يعدّون الأسرى فاقدي الحقّ في الحياة لوقوعهم في الأسر([231]).
وكان النخّاسون يتّخذون من الحروب الكثيرة التي اعتاد الروم على إشعالها مواسم لتجارتهم، وكانوا يصحبون الجيوش من أجْل أن يشتروا الأسرى والسبايا، من صبيان وبنات ورجال ونساء بأبخس الأثمان، حتى كان الغني من النخّاسين يشتري عدداً كبيراً من البشر في صفقة واحدة عقب نصر كبير. وبالرغم من كونها خزياً وعاراً إلّا أنّ تاريخ الاستعمار الروماني عدّها عظمةً ومجداً([232]).
وكان في روما سوق للرقيق تُعرض فيها هذه البضائع في المزاد العلني على ربوة مرتفعة، ويكون الرقيق عارياً من كلّ ما يستره ذكراً كان أم أنثى، صغيراً أم كبيراً، ولِمَن شاء من النّاس أن يدنو من هذا اللحم الحي المعروض للبيع فيجسّه بيده ويقلبه كيف يشاء، ولو لم يشتره في النهاية([233]).
وقد وضع جستنيان (527ـ565م)([234]) عدداً من القوانين المتعلّقة بالرقيق للرأفة بهم، وحُسُن التعامل معهم، ودعا إلى تشجيع عتق الرقيق، ولكنّه لم يلغِِ الرقّ، وسمح باسترقاق فلّاحي الأرض([235]).
أمّا الفرس فإنّ إمبراطوريتهم كانت من أقدم الإمبراطوريات التي نشأت في العالم القديم، وكان التنافس شديداً بينها وبين الرومان، ممّا أدّى إلى حصول كثير من الحروب بينهما من أجل السيطرة على مناطق العالم، وفي هذه الحروب كان الفرس يحصلون على أعداد كبيرة من الأسرى، ومن بين تلك الحروب ما قامت به الإمبراطورة خماني (112ـ140م)([236]) ملكة الفرس، حيث قادت الجيش الفارسي لغزو الروم، وفعلا ألحقت بهم الهزيمة، وسبت منهم سبياً كثيراً([237]).
ولمّا تولّى سابور بن هرمز (309ـ379م)([238]) الحكم هاجم العرب فقتل وأسر منهم أعداداً كبيرة([239])، ثمّ توجّه إلى الروم وتمكّن من التغلّب عليهم وسبى منهم سبياً كثيراً([240])، وغزاهم سابور مرّة أخرى فقتل وسبى سبياً كثيراً منهم، وأسكن السبي مدينة بناها لهم، سُمِّيت إيران شهر سابور([241]).
لم يكن العرب بعيدين عمّا يحدث في الدول المجاورة لهم من السبي والأسر، حيث كان الرقّ منتشراً عندهم، وتعداد الرقيق ملفتا للنظر، واسترقاق العربي لأخيه العربي رائجاً بينهم، ولا يجدون فيه حرجاً، وكانت ظاهرة الإغارة والغزو بين القبائل العربية شائعة، فكانت القبائل القويّة تفرض سيطرتها على القبائل الضعيفة، ويحلّ لها ما تشاء من استعباد وبيع وإهداء، وفرض على الأسرى والسبايا القيام بأعمال تثقل كاهلهم، وذلك تحت ظروف معيشية متدنّية وغير لائقة في أبسط مقوّمات الحياة الضرورية للإنسان، وأحياناً يتعرّض الإنسان الذي يتنقّل من مكان إلى آخر بسبب التجارة أو زيارة الكعبة المشرّفة للخطف والأسر، ويُباع في الأسواق كأيّ سلعة تباع فيه([242]).
لقد وقعت بين القبائل العربية كثير من الحروب، أطلق المؤرِّخون عليها اسم الأيّام ([243])، أو الغارات([244])، وغالباً ما كان يُسمّى اليوم الذي تقع فيه الحرب باسم الموضع الذي وقعت فيه الحرب، أو بالشيء البارز فيها، أو بأسماء القبائل التي دارت بينهم الحرب. وقد حدثت عمليات سبي في هذه الحروب([245]). وكانت أكثر أسباب هذه الحروب ـ الأيّام ـ هو جور وتعسّف حكّام القبائل القويّة على القبائل الضعيفة الخاضعة لهم، وقد يكون سببها النزاع على ماء أو مرعى، أو الأخذ بالثأر، أو محاولة التخلّص من حكم قبيلة على أخرى بظهور شخصية قوية في القبيلة الخاضعة([246]).
وكان الأسرى في حروب العرب يوثقون بوثاق قوي حتى لا يتمكّنوا من الهرب، ثمّ يُنقلون إلى بيوت آسريهم، واذا كان الأسرى جماعة فيُنقلون إلى أحياء القبائل للنظر في أمرهم، ومنهم مَن يمنّ عليهم بإطلاق سراحهم، ومنهم مَن يُعطى هبةً للقادة أو المحاربين، أو يُبادَلون بأسرى حرب كانوا بأيدي المغلوبين، أو يُفدّون بمال، أو وسائل أخرى([247]).
إنّ جهاد العرب المسلمين في السنوات الأولى من تاريخ الدولة العربية الإسلامية وبعد هجرة رسول الله’ إلى المدينة المنوّرة، تَمثَّل في المعارك ـ الغزوات والسرايا ـ التي كانت تهدف إلى نشر الإسلام أو الدفاع عنه من مهاجميه المشركين والقبائل العربية، ومنها اليهودية التي أعلنت عداءها للإسلام والمسلمين، وقد حدثت في هذه المعارك عمليات أسر وسبي، وقد أقرّ الإسلام ذلك.
لقد كانت أعداد السبايا
والأسرى التي حصلوا عليها كبيرة من المعارك التي خاضوها مع أعدائهم في معركة بدر([248]) سنة
2هـ/623م، وفي غزوهم لبني
قريظة([249]) سنة
5هـ/626م، ومن حسمى([250]) عندما وُجِّهت
إليها سرية([251]) سنة
6هـ/627م، وفي معركة حنين([252]) سنة
8هـ/628م. وعند النظر في حصّة أعداد الأسرى والسبايا ـ التي قُدّرت بالآلاف([253]) ـ التي
كانت للمسلمين في معاركهم، نجد أنّها أرقام مبالغ فيها؛ لأنّها لا تنسجم مع مبادئ
الإسلام الحنيف، ولا تنسجم مع أخلاق الرسول’ الذي بُعث رحمةً للعالمين.
ولكن يمكن التساؤل هنا: لماذا لم يلغِِ الرسول’ عمليات السبي؛ وكيف كان تعامله مع الأسرى والسبايا؟
إنَّ بزوغ نور الإسلام على الحياة البشرية الذي حمل لواءه الرسول محمد’ غيّر كثيراً من الأمور التي كانت سائدة قبل ذلك، سيما ما يتعلّق بالأسرى والسبايا، لأنّها كانت منافية للأخلاق والقيم التي جاء بها الإسلام، فلا بدّ من تغييرها بما يجعلها متلائمة مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي رفع راية المساواة بين النّاس، فالأفضلية بينهم إنّما هي بالتقوى والإيمان([254])، كما جاء في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)([255])، وانسجاماً مع الآية الكريمة المتقدّمة كان موقف الرسول’ من الأسرى والسبايا موقفاً إنسانياً، أمّا سبب عدم إلغاء الرسول’ والمسلمين من بعده عمليات السبي هو وجود حروب بين المسلمين وأعدائهم، وهؤلاء الأعداء يستحلّون سبي واسترقاق المسلمين، لذلك لا بدّ أن تكون معاملة الرسول’ والمسلمين بالمثل لردعهم([256]).
قال الله تعالى: () فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)([257])، ومع ذلك فإنّ الإسلام وضع نظاماً لأسرى وسبايا الحرب لم يكن معروفاً قبل الإسلام، إذ عدّهم أرِقّاء بشرط أن يضرب الإمام عليهم الرقّ بسبب بقائهم على الكفر([258])، وأحياناً قبل أن يضرب عليهم الرقّ تحدث عملية تبادل الأسرى بين المسلمين والمتحاربين معهم، أو قد يمنُّ المسلمون على الأسرى والسبايا ويطلقون سراحهم بدون مقابل، وفي أحيان أخرى في مقابل أخذ الفداء منهم، أو قد يكلفونهم بعمل يؤدونه فيُطلق سراحهم، وهذا ما فعله الرسول’ مع أسرى معركة بدر، سيما الذين لم يكن بمقدورهم دفع الفدية، وكانوا يعرفون القراءة والكتابة، فاشترط الرسول’ عليهم بأن يفتدي كلّ واحد منهم نفسه، مقابل تعليم القراءة والكتابة لعشرة من أبناء المسلمين([259]).
ومن الجدير ذكره أنّ الوقوع
في الأسر عند المسلمين شيء مؤقت، قد يزول بالمنّ أو الفداء بعد انتهاء الحرب، وأنّ
كثيراً من الأسرى سوف لن يصبح رقيقاً يباع في أسواق النخاسة. وما وقع من قتل لبعض
الأسرى إنّما كان على نطاق ضيّق جدا وفي حالات خاصّة([260]). وأنّ
معاملة العبيد الرقيق تختلف عمّا كان موجوداً عند العرب قبل الإسلام، إذ إنّ
الشريعة الإسلامية أوجدت منافذ عديدة لعتق العبيد، منها المكاتبة([261])، وهي: شروط
معيّنة بين العبد وسيّده، بحيث يُعتق العبد إن إلتزم
بها([262])، وقد حثّ
القرآن الكريم على المكاتبة، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)([263]).
وقد أكّدت التعاليم الإسلامية على معاملة العبيد بالحسنى والسماحة والنبل، وحثّت على ذلك الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، قال تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)([264])، وقال رسول الله’:«شرّ النّاس من باع النّاس»([265])، وقال أيضاً: «يا أيّها النّاس ألا إنّ ربكم واحد وإنّ أباكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلّا بالتقوى»([266]). وقال: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يُكلّف من العمل إلّا ما يُطيق»([267])، وجاء عن رسول الله قوله: «مَن قتل عبده قتلناه، ومَن جدعه جدعناه»([268])، وقال أيضاً: « إخوانكم خَوَلُكُم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمَن كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل، وليُلبِسه ممّا يَلبس، ولا تكلِّفوهم ما يغلبهم»([269]).
وكان موقف الرسول’ من النساء المسبيّات موقفاً إنسانيّاً ذا معاملة حسنة، فعندما غزى الرسول’ بني المصطلق سنة 6هـ/627م إنتصرعليهم وسبى منهم، وكانت جُوَيريّة ـ وهي بنت سيّدهم الحارث([270])ـ قد وقعت في السبي فافتداها أبوها وأنكحها الرسول’، وقد أدّى هذا الزواج إلى أن يعتق المسلمون ما في أيديهم من سبي بني المصطلق؛ إكراماً لجويرية، فكان إسلامها وزواجها من الرسول’ بركةً على أهلها([271]).
وعندما وقعت عمّة عدي بن حاتم الطائي([272]) سبيّةً ـ وذلك عندما غزى المسلمون حيّها، وهي عجوز وكانت على النصرانية ـ أُوتيَ بها إلى المدينة فكلّمت الرسول’ بأن يمنّ عليها ويطلق سراحها، فأجابها إلى ذلك وقال لها: «اذهبي فأنت حرّة لوجه الله،فاذا وجدتِ أحداً يأتي أهلك فأخبرينا نحملك إلى أهلك». وهذا الحدثُ جعل عديَ بن حاتم الطائي يدخل إلى الإسلام، وفيما بعد صار له دور مهمٌّ في أحداث الإسلام([273]).
ولمّا فتح الرسول’ حصن ابن أبي الحقيق سنة 7هـ/628م([274]) أُوتي له بصفية بنت حيَي بن أخطب اليهودية([275])، ووضع عليها رداءه، وبهذا عرف المسلمون أنّ الرسول’ اصطفاها لنفسه([276]).
ويبدو أنّ زواج الرسول’ من الجواري جعل المسلمين فيما بعد يقومون بالزواج من الرقيق بعد عتقهم من دون حرج من ذلك.
ولولا الإسلام وسماحته
وعدالته ونبله لما تمكّن كثير من الرقيق
من إسهامهم في مجالات الحياة ونشاطاتها السياسية([277])
والاجتماعية([278])
والاقتصادية([279]) والفكرية([280]).
وخلاصة القول: إنّ الموقف من السبايا قد تغيّر في ظل الإسلام تغيّراً جذريّاً بالنظر إلى طبقة العبيد والأرقاء، بحيث أصبح مقياس التفاضل يختلف عمّا كان عليه قبل الإسلام، إذ تكّونت مقاييس جديدة في التفاضل، كالتقوى والتقرّب من الله تعالى، وكذلك أمرت التعاليم الإسلامية المسلمين بإظهار العطف والرحمة وحُسن المعاملة مع الأسرى والسبايا، لاسيما النساء اللواتي يقعنَ في الأسر.
وبعد هذه الشواهد التاريخية من الرحمة والحُسنى والإنسانية التي اتّصف بها الرسول’ في تعامله مع المرأة المسبيّة غير المسلمة وبغض النظر عن جنسها أو لونها، سواء كانت عربية أم غير عربية؛ فكيف يكون حاله وهو يرى بناته سبايا بأيدي المسلمين، وقد قتلوا أبناءهنَّ وإخوانهنَّ وأزواجهنَّ، ونهبوا حجابهنَّ وحليّهنَّ وأموالهنَّ، وربطوهنَّ بالحبال، وساقوهنَّ بالسياط من بلد إلى آخر، في حالة ذعر وخوف وذلّ وهوان يتفرّج عليهنَّ النّاس؟! وهذا ما لم يُفعل حتى مع نساء اليهود والديلم عند وقوعهنَّ في السبي.
مفهوم آل البيت ^ لغةً واصطلاحاً
الهدف من الحديث عن مفهوم آل البيت أو أهل البيت ومكانتهم في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة هو لمعرفة المراد من هذا المفهوم، وتحديد المصاديق له، ومن ثَمَّ بيان قُدسيّة أهل هذا البيت، وهل يجوز قتل رجاله وسبي نسائه؟
وهنا سيعرف كلّ ذي لبّ وكلّ منصف ومتجرّد من الأهواء والميول ـ أيّاً كان دوافعها ـ هل ما حصل لآل البيت كان فعلاً إسلاميّاً يقرّه الإسلام؟ وهل ينسجم مع المروءة العربية عند العرب قبل الإسلام؟
أولاً: تحديد مفهوم الآل والأهل لغةً
لقد عرّف علماء اللغة معنى (الآل) و (الأهل) والفرق بينهما، حيث أشار الفراهيدي إلى أنّ أهل الرجل: زوجه، وأخصّ النّاس به([281])، قال الله تعالى: (فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا)([282]). ومعنى أهل البيت: سُكّانه، وأهل الإسلام: مَن يعتنقه ويدين به؛ لذا يقال فلانٌ أهل كذا أو كذا. وجاء في القرآن الكريم ما يدلّ على ذلك، قال الله تعالى: (أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ)([283])، وجمع لفظة الأهل: أهالي وأهلون وأهلات([284]).
وقال الجوهري: «آل الرجل: أهله وعياله...»([285])، وأمّا ابن فارس فقد قال: «آل الرجل: أهل بيته...؛ لأنّه إليه مآلهم وإليهم مآله، وهذا معنى قوله: يا آل فلان»([286]).
لم يتّفق علماء اللغة على أصل لفظة (آل)، فمنهم من قال: إنّ أصل لفظة آل أهل، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري بقوله: «أصل آل أهل، فأُبدِلت الهاء همزة ثمّ ألفاً يدلّ عليه، وتصغيره أُهيل»([287])، وأشار ابن منظور إلى أنّ «أصلها أهل، ثمّ أُبدِلت الهاء همزة فصارت في التقدير أَأْل، فلمّا توالت الهمزتان أبدلوا الثانية ألفاً، كما قالوا: آدم وآخر، وفي الأفعال آمن وآزر»([288]). وكان يخصّ للآل الأشرف الأخص دون الشائع الأعم، فلا يُقال: آل الخياط وآل الإسكافي، وإنّما يقولون: القرّاء آل الله تعالى، واللهم صل على محمّد وعلى آل محمد([289])، وكذا ما جاء في قوله تعالى: (وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ)([290]). وهناك قول آخر لأصل لفظة (آل) على أن أصلها أوْل، وهذا ما ذهب إليه الأزهري بقوله: «الآل من الأوْل وهو الرجوع، وقد آل يؤول أولاً»([291])، وأشار الجوهري إلى «أنّ أصل الآل التأويل، تفسير ما يؤول إليه الشيء، وقد أولته وتأاولته تأولاً»([292]).
إنّ لفظة (أهل) تستوعب معاني عدّة، وتكون أكثر وضوحاً عندما تُضاف إليها قرينة، فقد أشار علماء اللغة إلى أنّ المراد من أهل القرى سكانها، وأهل الشيء أصحابه، وأهل الكتاب أتباعه وقرّاؤه، مثل أهل التوراة وأهل الإنجيل([293]).
ثانياً: أهل البيت في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة
لقد وردت لفظة (أهل البيت) في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، الأول في قصّة ابراهيم× في قوله تعالى: (قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)([294])، والثاني في قصّة موسى×: (قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ)([295])، والثالث تخصّ آل محمد’، وذلك في قوله سبحانه: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([296]).
وأما لفظة آل فقد وردت في مواضع كثيرة، فضلاً عن الأسماء الظاهرة المشهورة، قال تعالى: (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ([297])، وقال سبحانه: (كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ)([298])، وقال: (وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)([299])، وقال تعالى: (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ)([300])، وقال سبحانه: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ)([301]).
أمّا في السنّة النبوية الشريفة، فقد وردت لفظة (العترة) للدلالة على أهل البيت، والعترة هي: ولد الرجل وذريّته وعقبه من صلبه. قال ابن الأعرابي: «عترة النبي ولد فاطمة البتول»([302])، وأشار مجد الدين بن الأثير إلى أنّ عترة الرجل أخصّ أقاربه، وعترة النبي بنو عبد المطّلب. وقيل: أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده([303])، واستدلّ ابن منظور على أنّ لفظة العترة تدلّ على أهل البيت؛ مستنداً في ذلك على قول الرسول’ نفسه: «إنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي»، فجعل العترة أهل البيت([304]). وقد أورد ابن حنبل لفظة آل البيت مضافة إلى الرسول’، وذلك في قول الرسول’ نفسه: «اللهم أجعل رزق آل بيتي قوتاً»([305]).
وقد حدّد حديث الكساء مصاديقَ أهل بيت النبي’، وهم: الإمام علي بن أبي طالب، والسيّدة فاطمة بنت محمّد، وولديهما الإمامين الحسن والحسين^. فقد جاء حديث الكساء مفسِّراً للفظة (أهل البيت) التي وردت في آية التطهير، حيث قال تعالى: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([306]).
وقد رُوي هذا الحديث عن بعض زوجات الرسول’، منهنّ: عائشة (ت58هـ/677م)، وأمّ سلمة (ت61هـ/680م)، فقد قالت عائشة: «خرج النبي غداةً، وعليه مرط([307])مرمّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثمّ جاء الحسين فدخل معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها، ثمّ جاء علي فأدخله، ثمّ قال: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)»([308]).
وجاء عن أمّ سلمة أنّه عندما نزلت آية التطهير «أرسل الرسول’ إلى علي وفاطمة والحسن والحسين، وجلّلهم بكساء، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامّتي([309])، أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا، قالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا نبيَّ الله؟ فقال: أنتِ على مكانكِ وأنتِ على خير»([310]).
ونقل حديثَ الكساء أيضا الإمامُ علي بن أبي طالب×، فقال: «جَمَعَنا رسول الله في بيت أمّ سلمة، أنا وفاطمة وحسن وحسين، ثمّ دخل رسول الله بكساء له وأدخلنا معه، ثمّ ضمنا، ثمّ قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. فقالت أمّ سلمة: يا رسول الله وأنا؟ ودَنَت منه، فقال الرسول: أنتِ على مكانكِ وأنتِ على خير، أعادها رسول الله ثلاثاً»([311]).
كما رَوى عدد من الصحابة حديث الكساء، ومنهم أبو سعيد الخدري([312])، وواثلة ابن الأسقع([313]).
وممّا يُؤكّد أنّ أهل البيت أو آل البيت هم: علي وفاطمة والحسن والحسين^ أنّ رسول الله كان يأتي باب علي وفاطمة÷([314]) مدّة ستّة أشهر([315])، أو مدّة تسعة أشهر، وفي كلّ يوم خمس مرات عند وقت كلّ صلاة، ويقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)»([316]). وبهذا كشف الرسول’ عن وجه الحقيقة في معنى الآية بما لا يقبل الشكّ.
كما بيّن الرسول’ منزلة أهل البيت للأمّة بقوله: «الحسن والحسين إماما أمّتي بعد أبيهما، وسيّدا شباب أهل الجنّة، وأمّهما سيّدة نساء العالمين، وأبوهما سيّد الوصيين، ومن ولْد الإمام الحسين تسعة أئمّة تاسعهم القائم من ولْدي، طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم، والمضيّعين لحرمتهم بعدي، وكفى بالله وليّاً وناصراً لعترتي وأئمّة أمّتي، ومنتقماً من الجاحدين لحقّهم، (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)»([317]). وعن الإمام الحسين بن علي÷ يقول: «سمعت جدّي رسول الله يقول: مَن أحبّ أن يحيا حياتي ويموت ميتتي، ويدخل الجنّة التي وعدني ربي، فليتولّ علي بن أبي طالب وذريّته الطاهرين، أئمّة الهدى، ومصابيح الدجى من بعده، إنّهم لم يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلال»([318]).
لقد أصبحت مفردات: (أهل البيت)، (آل البيت)، (العترة) متعارفاً عليها بين المسلمين، وأنّ المقصود منها جميعها الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين^([319])، ويلحق بهم الأئمّة التسعة من ولْد الإمام الحسين^، وما يُؤكّد ذلك هو حوار الإمام السجّاد علي بن الحسين÷ ـ وهو أول الأئمّة التسعة ـ مع الرجل الشامي عند دخول سبايا آل البيت دمشق وبالقرب من باب توما([320])، إذ إنّ الرجل الشامي كان يعتقد أنّ هؤلاء السبايا هم خوارج، وفقاً للدعاية الأموية، إلّا أنّ الإمام علي ابن الحسين÷ حاوره، وذكّره بعدد من الآيات القرآنية التي نزلت بحقّ أهل البيت([321])، ومن بين تلك الآيات آية التطهير (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)، وقال له الإمام: «نحن أهل البيت الذين خصّنا الله تعالى بهذه الآية»، ممّا جعل الرجل يندم على ما بدر منه، وبدأ يدعو الله تعالى لأن يغفر له ويتوب عليه([322]).
وكذا هناك مواقف أخرى تبيّن أنّ لفظ أهل البيت صار معروفاً في أوساط المجتمع ولدى أعدائهم قبل محبيهم، فقد كان هذا اللفظ يجري على لسان أحد جنود جيش ابن زياد، وذلك عند دخوله خيام الإمام الحسين× بعد قتله؛ لسلب النساء ونهب ما موجود في هذه الخيام من متاع، حيث أقرّ هذا الجندي للسيّدة زينب‘ أنّه يبكي على أهل البيت لما حلّ بهم وجرى عليهم([323]). وعندما عقد ابن زياد مجلساً في مسجد الكوفة الأعظم، ليُعلن للنّاس عن انتصاراته المزعومة بقتله الحسين وأهله وأنصاره، وسبي عياله؛ انتفض عبد الله بن عفيف الأزدي([324]) معارضاً على ابن زياد وفعله، وكان يردّد لفظة أهل البيت في ردوده على ابن زياد، ويقصد بهم آل بيت الرسول’، وبضمنهم الإمام الحسين×، وقد دفع حياته ثمناً لذلك([325]).
ولقد نزلت آيات عديدة في حقّ أهل البيت^ تدعو المسلمين إلى محبتهم، ففي آية المودّة قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)([326])، وعندما سُئل الرسول’ عن القربى التي وجبت على المسلمين محبتهم؛ أجاب قائلاً: «علي وفاطمة وولداهما»([327]).
كما حثّ الرسول’ المسلمين على التمسّك بآل بيته^ ومحبتهم في عدد من الأحاديث، رُوي عن أبي بكر (11ـ13هـ/632ـ634م) أنّه قال: رأيت رسول الله خيّم خيمةً وهو متكئ على قوس عربية، وفي الخيمة علي وفاطمة والحسن والحسين، فقال: «معشر المسلمين أنا سلم لِمَن سالم أهل الخيمة، وحرب لِمَن حاربهم، ووليٌ لِمَن والاهم، لا يحبّهم إلّا سعيد الجَدّ، طيّب المولد، ولا يبغضهم إلّا شقي الجَدّ ردئ الولادة»([328])، وفي حديث الثقلين قال الرسول’: «وإنّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبلٌ ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنّ اللطيف الخبير أخبرني أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض، فأنظروني بما تخلفوني فيهما»([329])، وقال الرسول’:« أدِّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبّ نبيكم، وحبّ أهل بيته، وقراءة القرآن»([330])، وقال ’ أيضاً:«... أُذكّرُكُم الله في أهل بيتي، اذكّركم الله في أهل بيتي، اذكّركم الله في أهل بيتي... »([331]).
وإتماماً لما تقدّم لا بدّ من الإشارة إلى أمر مهمّ يتعلّق بمحبّة أهل البيت^، وهو أنّ محبّة أهل البيت^ لا تكفي إلّا أن تكون محبّة صادقة، مقرونة بالعمل والتقوى والإيمان، ولا إيمان بلا عمل. وقد شرط الرسول’ في قبول العبادة أن يكون معها حبّ أهل البيت^ بقوله: «لو أنّ عبداً عبد الله بين الصفا والمروة ألف عام، ثمّ ألف عام، ثمّ ألف عام، ثمّ لم يًدرك محبتنا لأكبّه الله على منخريه في النّار»([332])، وقال أبو جعفر محمّد الباقر× (ت 114هـ/732م) ـ وهو الإمام الخامس عند الشيعة الإمامية ـ للصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري: «يا جابر أيكتفي مَن ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيت؟! فوالله ما شيعتنا إلّا مَن اتقى الله وأطاعه»([333]).
توخّى عبيد الله بن زياد ـ وهو الوالي الأموي للكوفة ـ عدّة اعتبارات وغايات لسبي عائلة آل البيت^، بعد قتل رجالهم ومَن كان معهم من نساء قتلى أنصار الإمام الحسين×، منها التشهيّر بعائلة أهل البيت، حيث نشر من خلال وسائله الدعائية الإعلامية أنّ الإمام الحسين× خارجي([334])، خرج عن طاعة خليفة المسلمين يزيد بن معاوية، وأنّه أراد أن يُفرّق وحدة كلمة الأمّة ويشقّ صفّ المسلمين. وكذلك من غاياته إعطاء درس وعبرة وتبديد الهالة القدسية للحسين وأهل بيته^، وإدخال الخوف والرعب في قلوب كلّ مَن يريد الخروج من الثائرين ضد السلطة الأموية، وأنّ حاله سيكون كحال الإمام الحسين×، حيث سيُقتَل وتُسبى عائلته. وأشار محمّد مهدي شمس الدين إلى « أنّ اجراءات السلطة الأموية في حماية نفسها لا تتوقّف عند حدّ، ولا تعترف بأيِّ قداسة أو عُرف ديني أو اجتماعي، وأنّها عازمة على سحق كلّ ثورة»([335]).
لقد تحرّك عمر بن سعد وجيشه من الطفّ قاصداً الكوفة بعد ظهر اليوم الحادي عشر من المحرم، أي بعد المعركة بيوم([336])، ومعه السبايا من حُرَم الإمام الحسين×، زوجاته، وبناته، وأخواته، ونساء إخوته، وبني عمومته، وجواريه، وعيالات الأنصار، والصبيان مثل الإمام محمّد الباقر بن علي السجاد، ومحمّد بن العباس، ومن الغلمان زيد وعمر أولاد الحسن السبط، ومن الرجال علي بن الحسين÷، وكان يشكو المرض. ومن الموالي عقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة الإمام الحسين×، وعلي بن عثمان بن الخطاب المغربي. وسيّروا الجميع على أقتاب([337]) الجمال بغير وطاء([338])، كما تُساق سبايا الأجانب([339]).
ولم نجد في المصادر التي بين أيدينا، رأياً قاطعاً دقيقاً بشأن عدد الأسرى من الرجال، والسبايا من النساء، بل هناك روايات لا تستقيم مع الواقع، منها:
أشار ابن سعد (ت230هـ/844م) إلى أنّه لم يسلم من أهل بيت الحسين بن علي والذين معه إلّا خمسة رجال، وهم: علي بن الحسين الأصغر حيث كان مريضا، وحسن بن حسن بن علي([340])، وعمرو بن حسن، والقاسم بن عبد الله بن جعفر، ومحمّد بن عقيل الأصغر. ومن النساء ستّ، وهنَّ: زينب وفاطمة بنات علي، وفاطمة وسكينة بنات الحسين، والرباب زوجة الإمام الحسين، وأمّ سكينة وعبد الله الرضيع، وأمّ محمّد بنت الحسن بن علي زوجة علي بن الحسين، وموالي ومماليك عبيد وإماء([341]).
وأشار الدينوري
(ت282هـ/895م) إلى أنّ عدد الأسرى من الرجال أربعة، وهم: علي بن الحسين÷ وقد رهق،
وعمر وله من العمر أربع سنين، دون ذكر
اسم والده، ورجلان أحدهما المرقع بن ثمامة الأسدي([342])، بعث به
عمر بن سعد إلى ابن زياد فسيّره إلى الربذة([343])، ولم يزل
بها حتى وفاة يزيد وهروب ابن زياد إلى الشام([344])، فرجع
المرقع إلى الكوفة، والآخر عقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة الحسين بن علي، وأرادوا
قتله لكن ما إن عرفوا أنّه عبد أخلوا سبيله([345]).
وأشار ابن عبد ربّه (ت328هـ/939م) إلى أنّ عدد الأسرى من الرجال هـو اثنا عشر غلاماً من بني هاشم، وأكبرهم يومئذ علي بن الحسين (السجّاد)، ومعه ابنه محمّد (الباقر)([346]).
وأشار أبو حنيفة النعمان المغربي (ت363هـ/973م) إلى أنّ الذين أُسِروا من الرجال عشرة، وهم: علي بن الحسين (السجّاد)÷ وهو مريض، وعمره ثلاث وعشرون سنة، وابنه محمّد الباقر وهو صغير، والحسن المثنّى، وعبد الله([347])، وعمرو، ومحمّد أولاد الحسن السبط، والقاسم بن عبد الله بن جعفر، ومحمّد بن عقيل، والقاسم بن محمّد بن جعفر، وعبد الله بن العباس بن علي. ومن النساء أربع، وهنَّ: أمّ كلثوم وأمّ الحسن بنات علي، وفاطمة وسكينة بنات الحسين([348]). وهناك مَن أشار إلى أنّ عدد السبايا من النساء كان عشرين امرأة([349]).
وكانت عائلة الإمام الحسين× قد خرجت معه من المدينة إلى مكّة، ومن ثمّ إلى العراق، وهم عامّة أهل بيته من بني أبي طالب، نسائه وأخواته وبناته وأبنائه وأخوته وأبناء إخوته وأبناء عمومته وأبنائهم ونسائهم ومواليهم، وبعض أنصاره، أمّا أخاه محمّد بن الحنفية فإنّه بقي في المدينة المنوّرة؛ ليكون للحسين عيناً يوافيه بالأخبار([350]).
وأشار الباحث لبيب بيضون إلى أنّ عددهم كان مائة وثلاثة وعشرين شخصاً، وتوزيعهم وفق التالي:
أ ـ الذكور:
1 ـ أولاد الإمام علي بن أبي طالب×، وحفيده محمّد بن العباس؛ ثلاثة عشر.
2 ـ أولاد جعفر بن أبي طالب×، وأحفاده؛ ستة.
3 ـ أولاد عقيل بن أبي طالب وأحفاده، ما عدا مسلم بن عقيل×؛ ستّة عشر.
4 ـ أولاد الحسن بن علي× إثنا عشر.
5 ـ أولاد الإمام الحسين بن علي، وحفيده محمّد الباقر^؛ خمسة.
6 ـ موالي أهل البيت^ عشرة.
المجموع إثنان وستون([351]).
وهنا وقع الباحث في وهم؛ إذ يذكر أنّ للحسين أربعة أولاد مع حفيده محمّد الباقر، في حين أنّ المصادر التي بين أيدينا أشارت إلى أنّ للحسين أربعة أولاد، وهم: علي الأكبر([352])، وقد قُتل مع أبيه في الطفّ، وأمّه ليلى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفية، ولا عقب له. وعلي الأصغر (السجاد)، وكنيته أبو محمّد، وأمّه شاه زنان بنت كسرى يزدجرد (632ـ652م) آخر ملوك الفرس، ولم يُقتل في الطفّ وفيه العقب. وجعفر وأمّه قضاعية، وتُوفي في حياة أبيه، ولا عقب له. وعبد الله الرضيع، وأمّه الرباب بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية، وقُتِل يوم الطفّ([353]). وبهذا فإنّ الذين خرجوا مع الإمام الحسين× إلى الطفّ، ثلاثة من أولاده، قُتِل منهم إثنان ونجا واحد فقط، فضلاً عن نجاة حفيده محمّد الباقر، وبهذا يكون مجموع الذكور واحداً وستين، وليس إثنين وستين.
ب ـ الإناث:
1 ـ زوجات الإمام علي بن أبي طالب× ثمان.
2 ـ بنات الإمام علي بن أبي طالب× ثلاث عشرة.
3 ـ زوجات الإمام الحسن السبط× خمس.
4 ـ بنات الإمام الحسن السبط× أربع.
5 ـ زوجات الإمام الحسين× أربع.
6 ـ بنات الإمام الحسين× ثلاث.
7 ـ زوجات عقيل بن أبي طالب ستّ.
8 ـ بنات عقيل خمس.
9 ـ زوجات عبد الله بن جعفر إثنتان.
10 ـ نساء مختلفات إثنتان.
11 ـ الجواري تسع.
المجموع إحدى وستون([354]).
وهناك مَن أشار إلى أنّ عدد زوجات الإمام علي بن أبي طالب× يوم استشهاده أربع زوجات حرائر بعقد نكاح، وهن: أم البنين الكلابية، وأسماء بنت عميس الخثعمية، وأمامة بنت أبي العاص، وليلى بنت مسعود التميمية، وأمّهات ولد عشر إماء([355])، وإنّ أمامة بنت أبي العاص (ت50هـ/670م) قد تزوّجت بعد استشهاد الإمام علي× من المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب([356])، وتُوفّيت عنده في عهد معاوية بن أبي سفيان([357]) (41ـ60هـ/661ـ679م). كما تزوّجت ليلى بنت مسعود التميمية بعد استشهاد الإمام علي× أيضا من ابن أخيه عبد الله بن جعفر([358])، وهذا يعني أنّ هناك اثنتين من أزواج الإمام علي× لم تخرجا إلى الطفّ مع الإمام الحسين×، وبهذا فانّ عدد زوجات الإمام علي× اللاتي خرجنَ مع ولده الإمام الحسين× إلى الطفّ ستّ، وليس ثمان.
وهناك من المصنفين المحدثين مَن يشير إلى عدم خروج زوجة الإمام الحسين× ليلى بنت أبي مرّة بن مسعود الثقفي، أمّ علي الأكبر إلى الطفّ، ولعلّها متوفاة قبل ذلك([359]). وبهذا يكون عدد نساء الحسين، اللاتي خرجن معه إلى الطفّ ثلاثاً، وليس أربعاً.
وأشارت المصادر إلى أنّ عدد بنات الحسين اللاتي كنَّ معه اثنتان، وهما: سكينة وفاطمة([360])، وأنّهما خرجتا إلى الطفّ مع أبيهما، وبهذا يكون عدد بنات الحسين اللاتي خرجن معه إلى الطفّ اثنتين وليس ثلاثة، وكان لهما دور في معركة الطفّ، وفي أيّام السبي.
وأشار ظهير الدين أبو الحسن علي بن زيد (بن فندق) البيهقي (ت565هـ/ 1169م)، إلى روايتين متناقضتين، فمرةً يقول: بأن للإمام الحسين× أربع بنات هنَّ: سكينة وأمّها الرباب، وفاطمة وأمّها أمّ إسحاق بنت طلحة، وزينب وأمّ كلثوم وأمّهما شهربانويه بنت يزدجرد ملك فارس (632ـ652م)، وماتتا وهما صغيرتان([361])، وهما شقيقتا علي بن الحسين÷، وأكبر منه، لأنّ أمّه ماتت عند الطلق في ولادته([362])، وذلك سنّة 33هـ/653م([363])، وقيل في مدّة النفاس([364])، وقيل في طفولته([365]).
ومرّة أخرى وبعد صفحات قليلة من روايته الأولى يقول البيهقي: بأنّه لم يبق من أولاد الإمام الحسين×، إلّا علي (زين العابدين) وفاطمة وسكينة ورقية([366])، وبسبب هذا التناقض الذي بدا واضحاً عند البيهقي، لعدم استقراره على حالة واحدة حول عدد وأسماء بنات الإمام الحسين×؛ يكون من الصعب الأخذ برواياته، لذا من المحتمل أن يكون لفظ رقية لقباً لإحدى بنات الإمام الحسين×، وربما لفاطمة([367]).
وبهذا يكون عدد الإناث اللاتي خرجن مع الحسين إلى الطفّ سبعاً وخمسين فقط.
ووفقاً إلى ما أشرنا إليه أعلاه من أنّ عدد الذكور واحدٌ وستون، وأنّ عدد الإناث سبع وخمسون؛ فيكون المجموع الكلي مائة وثمانية عشر، وليس مائة وثلاثة وعشرين.
وقد فصّل الباحثون في مَن خرج مع الإمام الحسين× من أهل بيته، وكما يلي:
من زوجات أبيه علي ثمان، وهنّ:
1 ـ الصهباء التغلبية، ومعها ابنتها رقية الكبرى زوجة مسلم بن عقيل، ومع رقية ابنتها عاتكة، وولداها عبد الله ومحمّد.
2 ـ أمّ مسعود بنت عروة الثقفي، جاءت مع بنتها رملة.
3 ـ ليلى بنت مسعود الدارمية التميمية، ومعها ولداها أبو بكر (عبد الله) ومحمّد الأصغر.
4 ـ أمّ زينب الصغرى، ومعها ابنتها رقية.
5 ـ أمّ فاطمة، ومعها ابنتها فاطمة.
6 ـ أمّ خديجة، ومعها ابنتها خديجة الصغرى.
7 ـ رقية الصغرى.
8 ـ أمامة بنت أبي العاص العبشمية([368]).
وقد أشرنا سابقاً، بأن كلا من أمامة بنت أبي العاص، وليلى بنت مسعود التميمية، لم تخرجا إلى الطفّ؛ بسبب وفاة إحداهما، وزواج الأخرى.
ومن أخواته ثلاث عشرة أختاً، هنَّ:
1 ـ زينب الكبرى العقيلة×، وأمّها السيّدة فاطمة بنت الرسول’.
2 ـ أمّ كلثوم الوسطى، وأمّها أمّ ولد.
3 ـ خديجة، وأمّها أمّ ولد، وزوجها عبد الرحمن بن عقيل، وأنجبت له سعداً وعقيلاً، وعبد الرحمن هذا قُتِل في الطفّ، وماتَ ولداه من شدّة العطش والدهشة والذعر عند هجوم جيش ابن سعد على المخيّم.
4 ـ رقية الكبرى، وزوجها مسلم بن عقيل، وأنجبت له عبد الله ومحمّداً اللذينِ قُتِلا يوم الطفّ، وبنتها عاتكة وعمرها سبع سنوات، سحقتها الخيول يوم الطفّ عند هجوم جيش ابن سعد على المخيّم.
5 ـ أمّ هانئ، وأمّها أمّ ولد، وزوجها عبد الله الأكبر بن عقيل، وأنجبت له محمّداً الأوسط.
6 ـ زينب الصغرى، وأمّها أمّ ولد، وزوجها محمّد بن عقيل، وأنجبت له عبد الله.
7 ـ رملة الكبرى، وأمّها أمّ مسعود بنت عروة، وزوجها عبد الرحمن الأوسط ابن عقيل، وأنجبت له أمّ عقيل.
8 ـ رقية الصغرى، وأمّها أمّ ولد.
9 ـ فاطمة، وأمّها أمّ ولد، وزوجها أبو سعيد بن عقيل الأحول، وأنجبت له حميدة ومحمّداً، ومحمّد هذا عمره سبع سنين، وعندما قُتِل الإمام الحسين×، وتصارخت النسوة، خرج مذعوراً بباب الخيمة ماسكاً بعمودها، فجاءه سهم وقع في خاصرته فقتله.
10 ـ خديجة الصغرى، وأمّها أمّ ولد، وزوجها عبد الله الأوسط بن عقيل.
11 ـ أمّ سلمة، وأمّها أمّ ولد.
12 ـ ميمونة، وأمّها أمّ ولد، وهي أخت أمّ سلمة.
13 ـ جمانة، وكنيتها أم جعفر، وأمّها أمّ ولد([369]).
كما خرجت عمّة الإمام الحسين× جمانة بنت أبي طالب، وبنت أخته زينب وتدعى أم كلثوم، مع زوجها القاسم بن محمّد بن جعفر([370]).
وخرجت تسع جوار لأهل البيت، أربع منهنّ لزينب، وهنّ:
1 ـ فضّة النوبية، جارية السيّدة فاطمة الزهراء‘.
2 ـ قفرة، ويُقال لها مليكة، خادمة الإمام علي بن أبي طالب×.
3 ـ روضة، مولاة رسول الله.
4 ـ سلمة، أمّ رافع، زوجة أبي رافع القبطي، مولى رسول الله.
5 ـ ميمونة، أمّ عبد الله بن يقطر، وهي حاضنة الإمام الحسين× وجاريته.
وأربع جوار لزوجات الإمام الحسين×، هنّ:
6 ـ فاكهة، أمّ قارب، خادمة الرباب.
7 ـ حنة أو حسينة، أمّ منجح، وهي تخدم في بيت علي السجاد×.
8 ـ كثبة أو كبشة، وتخدم أمّ إسحاق بنت طلحة التيمي، زوجة الإمام الحسين×.
9 ـ مليكة زوجة عقبة بن سمعان، وخدمت في بيت الإمام الحسن×، ثمّ الإمام الحسين×، مع زوجها الذي كان مولى للرباب([371]).
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ هذا العدد من النسوة ـ إن صحّ وجوده ـ هو الذي تعرّض للسبي من كربلاء إلى الكوفة، ثمّ إلى الشام.
وخرج مع الإمام الحسين× إثنا عشر أخاً، وهم:
1 ـ العباس×.
2 ـ عثمان.
3 ـ جعفر.
4 ـ عبد الله.
وهؤلاء الأربعة أمّهم أمّ البنين الكلابية.
5 ـ إبراهيم.
6 ـ أبو بكر.
7 ـ عمر.
8 ـ عون.
9 ـ عبيد الله.
10 ـ العباس الأصغر.
11 ـ محمّد الأوسط.
12 ـ محمّد الأصغر.
13 ـ محمّد بن العباس بن علي بن أبي طالب، وهو صغير([372]).
وخرج من أولاد وأحفاد جعفر الطيار بن أبي طالب ستّة أشخاص، هم:
1 ـ عون بن جعفر الطيار، وأمّه أسماء بنت عميس.
2 ـ عون الأكبر بن عبد الله بن جعفر، وأمّه زينب بنت الإمام علي×.
3 ـ عون الأصغر بن عبد الله بن جعفر.
4 ـ محمّد بن عبد الله بن جعفر، وأمّه الخوصاء من بني بكر بن وائل.
5 ـ عبيد الله.
6 ـ القاسم بن محمّد بن جعفر([373]).
وخرج من نساء عقيل ستّ، ومن أولاده الذكور إثنا عشر، ومن بناته قُدّر عددهن خمساً، وهم:
1 ـ جعفر بن عقيل، وخرجت معه أمّه أمّ الثغر أو يُقال لها أمّ الحفصاء العامرية.
2 ـ عبد الله الأصغر بن عقيل.
3 ـ موسى بن عقيل، وأمّه أمّ البنين بنت أبي بكر بن كلاب العامرية، حيث كانت مع ولدها.
4 ـ علي بن عقيل، وأمّه أمّ ولد.
5 ـ أحمد بن عقيل، وأمّه أمّ ولد، وجاءت مع ولدها.
6 ـ عبد الله الأكبر.
7 ـ عبد الرحمن بن عقيل، ومعه ابنه.
8 ـ عون بن عقيل([374]).
وخرج من أحفاد عقيل مع الإمام الحسين×:
1 ـ عبد الله بن مسلم بن عقيل.
2 ـ محمّد بن مسلم بن عقيل.
وكل من عبد الله ومحمّد، وأمّهما رقية بنت الإمام علي× وكانت قد خرجت معهما، وقد قُتِلا في الطف.
3 ـ محمّد بن مسلم.
4 ـ إبراهيم بن مسلم.
وكل من إبراهيم ومحمّد صبيان، قُتِلا في الكوفة بعد أن فرّا من الطفّ، وأمّهما رقية الكبرى بنت الإمام علي×، وتوفيت أختهما عاتكة وعمرها سبع سنوات، إذ سحقتها الخيل عند الهجوم على المخيّم.
5 ـ سعد بن عبد الرحمن بن عقيل.
6 ـ عقيل بن عبد الرحمن بن عقيل.
وسعد وعقيل ماتا من شدّة العطش والخوف، وذلك عند هجوم الجيش على المخيّم.
7 ـ غلام محمّد بن أبي سعيد بن عقيل الأحول، وأمّه أمّ ولد.
8 ـ جعفر بن محمّد بن عقيل([375]).
وخرج مع الإمام الحسين× من زوجات أخيه الإمام الحسن× خمس نساء، ومن أولاده ستّة عشر شخصاً، إثنا عشر من الذكور، وأربع من الإناث، وهم:
1 ـ الحسن المثنّى بن الحسن السبط، وأمّه خولة بنت منظور الفزارية.
2 ـ عمرو بن الحسن.
3 ـ القاسم بن الحسن.
4 ـ عبد الله بن الحسن.
وهؤلاء الثلاثة أمّهم أمّ ولد.
5 ـ أحمد بن الحسن×، و له من العمر ستّة عشر سنة، و أختاه أمّ الحسن وأمّ الحسين، سُحقتا يوم الطفّ بعد شهادة الحسين×، لمّا هجم القوم على المخيّم للسلب، أمّهم أمّ بشير بنت أبي مسعود الخزرجية الأنصارية.
6 ـ محمّد بن الحسن.
7 ـ جعفر بن الحسن.
8 ـ أبو بكر بن الحسن.
9 ـ الحسين بن الحسن، الملقّب بالأثرم.
10 ـ طلحة بن الحسن.
والحسن وطلحة وأخت لهما تُدعى فاطمة، أمّهم أمّ إسحاق بنت طلحة بنت عبيد الله التيمي، وفاطمة زوجها علي السجّاد، وهي أمّ محمّد الباقر.
11 ـ زيد بن الحسن.
12 ـ عبد الرحمن بن الحسن.
وزيد وعبد الرحمن، كانت معهما أختهما أم الحسن (رملة)، وأمّهم أمّ ولد، كانت معهم في الطفّ([376]).
وخرج مع الإمام الحسين× من زوجاته أربع، ومن أولاده الذكور أربعة([377])، ومن بناته ثلاث، وهم كما يلي:
1 ـ علي الأكبر، وأمّه ليلى بنت أبي مرّة الثقفية.
2 ـ علي الأوسط، وهو زين العابدين×([378])، وأمّه شاه زنان بنت كسرى يزدجرد ملك الفرس، وكانت متوفّاة، ومعه أخته رقية.
3 ـ علي الأصغر، وأمّه سلافة.
4 ـ عبد الله الرضيع، وأخته سكينة، وأمّهما الرباب بنت أمرئ القيس الكلبية.
5 ـ فاطمة، وأمّها أمّ إسحاق بنت طلحة التيمي.
6 ـ وكان مع الإمام علي السجّاد ابنه محمّد الباقر×، وعمره ثلاث سنوات([379]).
وخرج من موالي أهل البيت مع الإمام الحسين× عشرة، و هم:
1 ـ الحارث بن نبهان، مولى الحمزة.
2 ـ سعد بن الحارث الخزاعي، مولى الإمام علي بن أبي طالب×.
3 ـ علي بن عثمان بن الخطاب الحضرمي.
4 ـ نصر بن أبي نيزر.
5 ـ سلمان بن أبي رزين.
6 ـ مسلم بن عمرو التركي.
7 ـ قارب بن عبد الله الدئلي الليثي.
8 ـ منجح بن سهل.
9 ـ عقبة بن سمعان، مولى الرباب.
10 ـ جون بن حوي النوبي، مولى أبي ذر الغفاري([380]).
ومن هذا العرض نجد أنّ الذين خرجوا مع الإمام الحسين× من أهله ومواليه، نساءً ورجالاً، صغاراً وكباراً، هم مئة وثلاثة وعشرون شخصاً، كما يذهب إلى ذلك الباحث لبيب بيضون، ولكن قد أشرنا آنفاً إلى أنّ أولاد الإمام الحسين× الذين خرجوا معه إلى الطفّ كانوا ثلاثة فقط، وبهذا يكون عدد الذكور واحداً وستين، وكذلك أشرنا إلى أنّ عدد زوجات الإمام علي بن أبي طالب×، اللاتي خرجنَ إلى الطفّ ستّ وليس ثمان، وعدد نساء الحسين اللاتي خرجنَ معه ثلاث وليس أربعاً، ومن بناته إثنتان وليس ثلاثاً؛ وبهذا يكون عدد الإناث سبعاً وخمسين، والمجموع الكلي هو مئة وثمانِ عشرة، ويظلّ هذا الرقم محلّ نظر وتأمل، فإنّه لم يكن قريباً إلى الواقع.
كما يُشار إلى أنّ عدد أنصار الإمام الحسين× ونسائهم الذين خرجوا معه إلى الطفّ، يقترب من عدد آل بني طالب، أولئك الذين خرجوا مع الإمام الحسين×([381])، وربما يكون هذا العدد صحيحاً عند خروج الإمام الحسين× من المدينة، ويبدو أنّ كثيراّ منهم تسرّب في طريق السير إلى العراق، وظلّ عددهم قليلاً. ولكنّ المصادر التي بين أيدينا لم تذكر لنا أسماء النساء زوجات أو جواري أنصار الإمام الحسين×، اللائي سبين مع سبايا أهل البيت× بعد انتهاء المعركة، إذ نعتقد وجود عدد منهنّ قد سبين، ولا نعرف هل بقين مع سبايا أهل البيت× عند السبي إلى الكوفة أو إلى الشام أم لا. إلّا أنّ بعض المراجع ـ وهي محلّ نظر وتامل ـ أشارت إلى وجود بعض نساء أنصار الإمام الحسين× من غير الطالبيين قد سبين مع سبايا أهل البيت إلى الكوفة، وتدخّلت قبائلهنّ عند ابن زياد، وطلبت منه إخراج تلك النسوة، ووافق على ذلك، وبهذا تخلصنَ من السبي إلى الشام([382]).
وذكرت الروايات التاريخية بعض نساء أنصار الإمام الحسين×، اللائي حضرنَ معركة الطفّ، وكان لهنّ دور واضح في المعركة، ومن بين تلك النسوة:
1. المرأة الأسدية([383])، زوجة علي بن مظاهر الأسدي([384]) الذي قُتِل يوم الطفّ، وقد حضرت معه المعركة، ورفضت أن تنصرف من المعركة بعد أن أذِنَ الإمام الحسين× لأنصاره بإرجاع نسائهم إلى مأمنهنّ، كي لا يتعرضنَ للسبي كما ستتعرض عائلته لذلك. لكن زوجة علي بن مظاهر رفضت الرجوع؛ وأبت إلّا أن تُواسي وتُشارك نساء أهل البيت بما سيجري عليهنّ([385]).
وهناك مَن ينفي مشاركة علي بن مظاهر الأسدي في معركة الطفّ([386])، ونحن لا نتّفق مع ذلك؛ اذ إنّ علي بن مظاهر لا بدّ من استجابته لدعوة أخيه حبيب بن مظاهر([387]) قبل الآخرين، عندما استأذن الأخير الإمام الحسين× في الذهاب إلى حي بني أسد. ويبدو أنّه كان قريباً من موضع الطفّ، ودعوتهم لنصرة الإمام الحسين× وعند وصوله إلى حيّهم، إذ قال حبيب لهم: «أدعوكم إلى نُصرة ابن بنت رسول الله، فأطيعوني اليوم في نصرته تنالوا شرف الدنيا والآخرة، إنّي أقسم بالله لا يقتل أحد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صابراً محتسباً، إلّا كان رفيقاً لمحمّد في أعلى عليّين»([388])، ولاقت دعوة حبيب هذه استجابةً، فاجتمع من رجال الحي تسعون رجلاً يُريدون التوجّه إلى الطفّ لنصرة الإمام الحسين×، إلّا أنّهم مُنِعوا بالقوّة من قِبَل جيش عبيد الله بن زياد([389]). وهنا نعتقد أنّ علي بن مظاهر قد التحق لنصرة الإمام الحسين×، مصاحباً لأخيه حبيب عند رجوعه إلى موضع الطفّ بعد هذه المهمّة.
2 ـ زوجة مسلم بن عوسجة الأسدي([390])، وهـو من شيوخ القرّاء([391])، وقد قُتِل زوجها وولدها، والذي يُدعى خلف([392]) يوم الطفّ([393]). وفي رواية أخرى أنّه عندما قُتِل ابن عوسجة صاحت جاريةٌ له: «يا ابن عوسجتاه يا سيّداه»([394])، وهذا يعني وجود امرأة أخرى، فضلاً عن زوجته، وهي جارية له قد صحبتهُ إلى الطفّ.
3 ـ أم وهب بنت عبد بن قاسط الكلبية([395])، وزوجة ولدها. خرج وهب بن عبد الله بن عمير الكلبي إلى الطفّ، ومعه أمّه وزوجته، وكانت أمّه تشجّعه على نصرة الإمام الحسين× في الطفّ، ولمّا قُتل يومئذ رُمي برأسه إلى معسكر الإمام الحسين×، فذهبت إليه زوجته، وبينما هي مشغولة في مسح الدم والتراب عن وجهه ضربها رستم غلام الشمر ـ بأمر من سيّده ـ بعمود على رأسها فماتت، وتُعدّ أول امرأة قُتِلت يوم الطفّ([396]).
وهناك مَن ينفي وجود وهب يوم الطفّ، وبالتالي لا
وجود لزوجته([397])، بل
الموجود هو عبد الله بن عمير الكلبي([398]) وزوجته
أمّ وهب([399])، وإنّ
وهب
ابن له([400])، وسواء
أكان المقتول وهب أم أباه، فإنّ أم وهب كانت موجودة في الطفّ، ويبدو أنّها قد تعرّضت
للسبي.
4 ـ بحرية بنت مسعود الخزرجية، قد صحبت زوجها جنادة بن كعب الأنصاري([401]) وابنها من مكّة إلى العراق، وقد قُتِل زوجها في الحملة الأولى، كما قتل ولدها الوحيد أيضا([402]) عمرو، وكان عمره حوالي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة سنة([403]).
5 ـ كما كانت هناك عجوز إسمها غير معروف قد حضرت معركة الطفّ، وقُتل زوجها وولدها في تلك المعركة([404]). وإنّ المصادر لم تذكر أسماء تلك النسوة اللائي قُتِل أزواجهنّ أو أبناؤهنّ في كثير من هذه الحالات، ممّا يجعلنا نعتقد وجود حالات مماثلة أخرى.
وبعد هذه الإشارات التاريخية المقتضبة حول مشاركة بعض نساء أنصار الإمام الحسين× في معركة الطفّ، فإنّنا نظنّ وجود أُخريات إلى جانبهنّ أدّينَ دوراً مماثلاً، وتعرضنَ للسبي أسوةً بنساء أهل البيت، إذ لا بدّ من إخراج كثير من أنصار الإمام الحسين× بعض نسائهم أو جواريهم. وفي دراسة معاصرة قدّر عدد الذين استُشهِدوا يوم الطفّ مع الإمام الحسين× من الأنصار غير الهاشميين خمسة وتسعين رجلاً([405]).
وحمل ابن سعد معه عند توجّهه إلى الكوفة رؤوس الذين استُشهِدوا مع الإمام الحسين×، من أهل بيته× وأنصاره بعد قطعها([406])، وقد تنافست القبائل في حملها إلى ابن زياد لتحظى بالقرب منه، ونيل جائزته.
اختلفت الروايات في عدد الرؤوس التي حُملت، حيث يذكر أبو مخنف (ت157هـ/773م) أنّ عددها سبعون رأساً، وقد جاءت كندة بثلاثة عشر رأساً، ويقودهم قيس بن الأشعث الكندي، وهوازن بعشرين رأساً، ويقودهم الشمر بن ذي الجوشن، وتميم بسبعة عشر رأساً، وبنو أسد بستّة رؤوس، ومذحج بسبعة رؤوس، وسائر الجيش بسبعة رؤوس([407]).
ويذكر البلاذري (ت279هـ/892م) أنّ عدد الرؤوس اثنان وثمانون رأساً، وقد جاءت كندة بثلاثة عشر رأساً، يقودهم قيس بن الأشعث، وهوازن بعشرين رأساً، يقودهم شمر بن ذي الجوشن، وتميم بسبعة عشر رأساً، وبني أسد بستة عشر رأساً، ومذحج بسبعة رؤوس، وقيس بتسعة رؤوس([408]).
ويذكر أبو حنيفة الدينوري (ت282هـ/895م) أنّ عدد الرؤوس اثنان وسبعون رأساً، جاءت هوازن باثنين وعشرين رأساً، وتميم بسبعة عشر رأساً، يقودهم الحصين بن نمير، وكندة بثلاثة عشر رأساً، يقودهم قيس بن الأشعث، وبنو أسد بستة رؤوس، يقودهم هلال الأعرج، والأزد بخمسة رؤوس، يقودهم عيهمة بن زهير، وثقيف باثني عشر رأساً، يقودهم الوليد بن عمرو([409]).
إنّ المتمعّن في الأعداد التي ذكرها أبو حنيفة يجدها خمسة وسبعين رأساً، وليست اثنين وسبعين رأساً كما ذكر.
ويذكر ابن طاووس (ت664هـ/1265م) أنّ عدد الرؤوس ثمانية وسبعون رأساً، جاءت كندة بثلاثة عشر رأساً، يقودهم قيس بن الأشعث، وهوازن باثني عشر رأساً، يقودهم شمر بن ذي الجوشن، وتميم بسبعة عشر رأساً، وبنو أسد بستّة عشر رأساً، ومذحج بسبعة رؤوس، وباقي الجيش بثلاثة عشر رأساً([410]).
ويذكر سبط بن الجوزي (ت654هـ/1256م) روايتين في عدد الرؤوس، جاء في الأولى أنّ عدد الرؤوس كان إثنين وتسعين رأساً([411])، وفي الثانية أنّ عدد الرؤوس يزيد على سبعين رأساً([412])، دون أن يفصّل في كيفية توزيع حملها بين القبائل.
كما أنّ هناك بعض القتلى لم تقطع رؤوسهم، أمثال الطفل الرضيع عبد الله بن الحسين× حيث دفَنه أبوه بعد قتله، وكذلك الحرّ بن يزيد الرياحي، لم تسمح عشيرته بقطع رأسه، بل أخذته ودفنته([413]).
إنّ هذا الإختلاف في عدد رؤوس قتلى الطفّ، مردّه إلى عدم معرفة عدد القتلى بشكل دقيق من قبل المؤرِّخين أعلاه، فهم لم يحدّدوا هذه الرؤوس وعددها، هل هي رؤوس أنصار الإمام الحسين× من غير الهاشميين أو الأنصار الهاشميين؟ وهم لم يخلطوا وحسب بين عدد قتلى الأنصار وقتلى بني هاشم، بل لم يصلوا إلى العدد الحقيقي للقتلى، وبالتالي إلى عدد الرؤوس، وقد توصّلت الدراسات المعاصرة إلى تحديد عدد القتلى من أنصار الإمام الحسين× من غير الهاشميين، وكان عددهم خمسة وتسعين ناصراً([414])، وعدد قتلى الأنصار الهاشميين مع الإمام الحسين× نفسه كان عددهم تسعة عشر رجلاً([415]).
وكان ابن سعد قد أرسل رأس الإمام الحسين× عصر يوم المعركة بعد انتهائها إلى الكوفة؛ ليُقدَّم إلى عبيد الله بن زياد بيد قاطع الرأس خولّي بن يزيد الأصبحي ويصحبه حميد بن مسلم الأزدي([416]).
روي عن النوّار بنت مالك الحضرمية([417]) إحدى زوجات خولّي ـ والتي لم توافق زوجها على فعله، وأخذت على نفسها عهداً بأن لا تجتمع معه في بيت واحد، وتركت فراشه منذ تلك الليلة ـ بأنّ الخولّى قد وصل برأس الإمام الحسين× ليلاً إلى قصر الإمارة، ووجد بابه مغلقاً فأتى منزله ووضع الرأس تحت إجّانة([418])، فرأت النوّار نوراً يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجّانة، وطيور بيضاء ترفرف حولها([419]).
وقيل: إنّه عندما أوتي بالرؤوس للكوفة، إذا بفارس أحسن النّاس وجهاً قد علّق في رقبة فرسه رأس غلام أمرد، كأنّه القمر ليلة تمامه، والفرس يمرح فإذا طأطأ رأسه استقر الرأس على الأرض، وكان هذا الرأس للعباس بن علي بن أبي طالب، والذي علّقه على رقبة فرسه حرملة بن كاهل الأسدي، الذي عُوقِب في الدنيا قبل الآخرة، حيث تحوّل وجهه إلى اللون الأسود، بل أشدّ سواداً من القار([420]).
وممّا يدلّ على خلوّ جيش الأعداء من الرحمة مرور ابن سعد ومعه السبايا عند تحرّكه نحو الكوفة، على مصرع الإمام الحسين× وأصحابه، وإن كان ذلك بطلب من السبايا أنفسهم، فهو صورة مروعة ومفزعة أخذت ما أخذته في نفوس نساء آل البيت السبايا، فتوجّعت زينب باكيةً منتحبةً، تنادي جدّها رسول الله بقولها: «يا محمّداه صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعراء، مرمّل بالدماء، مقطّع الأعضاء، يا محمّداه وبناتك سبايا، وذريّتك مقتّلة تسفى عليها الصبا...»([421])، والسيّدة زينب‘ في مناجاتها هذه مع جدّها رسول الله، قد أبكت كلّ ذي لبّ له قدر بسيط من الرحمة، ومع ذلك وبرباطة جأشها المعتاد عندما رأت ابن أخيها علي بن الحسين÷ قد أخذ منه الألم والتوجّع مأخذه عند رؤيته القتلى وجسد أبيه مقطّع الأوصال اتّجهت إليه تصبّره، وتطمئنه على المستقبل المشرق لثورة أبيه الإمام الحسين× بقولها: «ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدّي وأبي وإخوتي، فوالله إنّ هذا لعهد من الله إلى جدّك وأبيك، ولقد أخذ الله ميثاق ناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض، وهم معروفون في أهل السماوات، وهم يجمعون هذه الأعضاء المقطّعة فيوارونها، وينصبون بهذا الطفّ علماً لِقبر أبيك سيّد الشهداء، لا يدرس أثره، ولا يمحى رسمه على مرّ الليالي والأيام، وليجتهدنّ أئمّة الكفر لمحوه وطمسه، فلا يزداد أثره إلّا علوّاً»([422]).
كما رمت سكينة بنت الإمام
الحسين×([423]) بنفسها
على جسد أبيها عند رؤيته،
ولم يستطع أحد أن يرفعها منه إلّا بتجمّع عدد من الرجال وسحبهم إيّاها بقوّة([424])، وهذا ما
سولّت لابن سعد نفسه أن يمرّ بنساء ثواكل، ومعهنّ مريضهنّ قبل أن تجفّ دموعهنّ،
وتهدأ نفوسهنّ.
وقد جدّ ابن سعد ومَن معه من الجيش والسبايا في السير مسرعين إلى الكوفة، ولم يتوقّفوا في موضع النخيلة([425]) عند مرورهم بها؛ وذلك لأنّها لا تبعد كثيراً عن موقع الطفّ، حتى وصلوا عند غروب الشمس إلى مشارف الكوفة، وباتوا ليل الثاني عشر ـ كما يعتقد البعض ـ في موضع الحنّانة([426])، وعسكروا في هذا المكان القريب من مركز المدينة، حيث نزل الحرس الموكّل على حراسة السبايا والرؤوس، وضربوا الخيام والفساطيط، وأنزلوا سبايا آل البيت فيها، وباتوا يحرسونهم تلك الليلة حتى صباح اليوم التالي حيث دخلوا الكوفة([427]).
وفي صباح اليوم الثاني عشر من المحرم دخلوا إلى الكوفة، واستعرضوهم في شوارعها، وتخلّل ذلك خُطب السيّدة زينب الكبرى وأمّ كلثوم ابنتي الإمام علي بن أبي طالب، وفاطمة وأخيها علي بن الحسين^، ثمّ أُدخِلوا إلى مجلس عبيد الله بن زياد، وهذا ما سنتناوله في الفصل القادم.
ويُلاحظ ممّا تقدم:
ظاهرة السبي كانت موجودة عند دول الروم والفرس المجاورة للعرب، وكذلك موجودة عند قبائل العرب قبل الإسلام، وهي ظاهرة سياسية واجتماعية واقتصادية، وأنّ سببها الحروب المتواصلة بين تلك الدول أو القبائل، ممّا جعلهم يسبون ويأسرون نساء ورجال مَن انتصروا عليهم، ومن ثمّ يُسخّرونهم لأعمال شتّى في خدمتهم.
وقد ظلّت هذه الظاهرة عند بزوغ نور الإسلام، إلّا أنّه اتخذ إجراءات عدّة للقضاء على هذه الظاهرة، وتجفيف منابعها كلّما أمكن ذلك، التزاماً وتطبيقاً لمنهج الدين الإسلامي الحنيف، حيث أكّدت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة على تحقيق ذلك.
وقد اختلف التعامل في ظلّ الإسلام مع الأسرى والسبايا، من الشدّة والقسوة والظلم إلى التعامل بمنتهى الإنسانية من حيث الحسنى والرأفة والعدالة، من خلال ما فعله الرسول’ في معاملته مع الأسرى في حروب الدفاع عن الإسلام ونشره، وخاصّةً مع النساء، واستمّر ذلك إلى عهود تلت عصر النبوّة إبّان عمليات الفتح ونشر الإسلام في البلدان المجاورة لدار الإسلام. وقد أدّى هذا إلى زيادة أعداد السبايا والأسرى، ودخول كثير منهم في الإسلام واعتناقه. وقد حُرّر كثير منهم بطرائق شتّى، ممّا جعل بعضهم يُؤدّي دوراً بارزاً في جوانب مختلفة في دولة الإسلام.
إلّا أنّ ممَّن حُسِبوا على
الإسلام، بل وحكموا دولته، أمثال يزيد بن معاوية وواليه في الكوفة عبيد الله بن
زياد، ولأغراض سياسية باطنها الحقد والضغينة والتسلّط على رقاب المسلمين؛ قاموا
بارتكاب جريمة لا تُغتفر بقتلهم الإمام الحسين بن علي وأهل بيته^ وأنصاره
وهم عطاشى، ومن ثمّ سبي عيالهم، ونهب أموالهم، والتجوال بهم من بلد إلى آخر وهم
مقيّدون يُضربون بالسياط، ويتفرّج عليهم النّاس، هؤلاء هم آل البيت أو أهل البيت
الذين فرضت محبّتهم على البشر، وقد أكّد ذلك القرآن الكريم في عدد من آياته، فضلاً
عن أحاديث الرسول’ ووصاياه في عترته، إذ شدّد في التذكير به، ووجوب أن يخلفوه
خيراً فيهم.
الفصل الثاني
المبحث الأول: الاستعراض في شوارع الكوفة
المبحث الثاني: خطبة زينب بنت علي بن أبي طالب÷ في أهل الكوفة
المبحث الثالث: خطبة فاطمة بنت الحسين÷ في أهل الكوفة
المبحث الرابع: خطبة أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب÷ في أهل الكوفة
المبحث الخامس: خطبة علي بن الحسين (السجّاد)÷ في أهل الكوفة
المبحث السادس: دخول سبايا آل البيت^ قصر الإمارة
المبحث السابع: مجلس ابن زياد العام وأصداء المعارضة
الفصل الثاني: سبايا آل البيت^ في الكوفة
اتّخذ عبيد الله بن زياد عدّة إجراءات قبل دخول السبايا إلى الكوفة؛ خشيةً من ردود أفعال أهلها، وأن تتحرّك حميّتهم وغيرتهم، ويكون هناك فعل مضادّ للسلطة عند رؤيتهم سبايا أهل البيت^ وهم بتلك الحالة المأساوية،، فأمر بتعطيل الأسواق وغلق الدكاكين، وأمر بنشر عشرات من جنوده في دروب المدينة وسككها وشوارعها؛ للمحافظة على الأمن إن حدث حادث، وأمر بعدم حمل النّاس للسلاح يومئذ عند دخول السبايا الكوفة([428])؛ لأنّه كان من بين أهل الكوفة مَن يعلم بحقيقة الأحداث، ويدرك عظم المصاب، وفظاعة الجناية التي ارتكبتها السلطة الأموية، وتخاذل أهل الكوفة عن نصرة الإمام الحسين بن علي÷، ويعرف أنّ السبايا المحمولين مع عمر بن سعد هم بقية آل الرسول’، وأنّ الرؤوس المحمولة على أطراف الرماح هي رؤوس ابن رسول الله الإمام الحسين×وأهلبيته وأنصاره، وهم خير أهل الأرض، لذا فإنّ بكاءهم كان لعظم الرزية، ومنهم مَن كان هواه وميوله مع بني أميّة، أو جاهلاً لم يعلم بحقائق الأحداث، متوهّماً أنّ والي الكوفة ابن زياد قد فتح فتحاً جديداً في ثغور المسلمين، وجيء بهؤلاء السبايا من ذلك الثغر، وهم غير مسلمين، فكان هؤلاء يضحكون جهراً، ويتبادلون التهاني فيما بينهم عند لقائهم بعضهم لبعض بهذه المناسبة([429]).
لقد رسم عبيد الله بن زياد خطةً لدخول السبايا الى الكوفة، تتمثّل بدخول الجيش تتقدّمه الأبواق والرايات، ثمّ بعد ذلك رأس الإمام الحسين×على رمح طويل، وتليه رؤوس بقية أصحابه التي وُضِعت على الرماح أيضا، وأشهروها على الإعلام، ووراء ذلك تكون السبايا، ثمّ يدخل الجميع الكوفة، وكان كلّ ذلك قد أُعِد بطريقة احتفالية ابتهاجاً بالنصر، وإيحاءً للناس بأنّ الجيش الأموي قد حقّق نصراً كبيراً على أعدائه([430]).
وقد وُصِف رأس الحسين× وهو على رمح طويل، بأنّه «رأس زهري قمري، أشبه الخلق برسول الله، إتصل بلحيته الخضاب، فوجهه كدائرة قمر طالع، الريح تلعب به يميناً وشمالاً»([431]).
كما وصف مسلم الجصّاص([432]) والذي كان يقوم بترميم دار إمارة الكوفة، بقوله: «بينما أنا أُجصّص الأبواب وإذا أنا بزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة، فأقبلت على خادم كان معنا، فقلت: ما لي أرى الكوفة تضجّ؟ قال: الساعة أتوا برأس خارجي خرج على يزيد، فقلت: مَن هذا الخارجي؟ قال: الحسين بن علي، قال: وتركت الخادم حتى خرج، ولطمت وجهي حتى خشيت على عيني أن تذهب، وغسلت يد4ي من الجصّ، وخرجت من ظهر القصر، وأتيت إلى الكناس([433]) إحدى محلات الكوفة، فبينما أنا واقف والنّاس يتوقّعون وصول السبايا والرؤوس إذ أقبلت نحو أربعين شقة تُحمل على أربعين جملاً، فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة، وإذا علي بن الحسين على بعير بغير وطاء»([434])، ويستمرّ الجصّاص في وصفه للإمام علي بن الحسين÷: «وأوداجه تشخب دماً»([435]).
وعلى الرغم من أنّ هذه الرواية تصف لنا حال السبايا عندما جاؤوا بهم إلى الكوفة، إلّا أنّ الملاحظ عليها أنّها رواية مرسلة، كما أنّ المحامل والهوادج لم يرد ذكرها إلّا في خبر مسلم الجصّاص، فضلا عن أنّ نسبة شجّ الرأس ونسبة الأشعار المعروفة إلى السيّدة زينب‘، التي ألقتها عند دخولهم الكوفة، بعيدة عن هذه المخدّرة عقيلة الهاشميين، العالمة غير المعلمة، صاحبة مقام الرضى والتسليم([436]).
ومن المعروف أنّه قد جاء في المصادر التي أشارت إلى ورودهم إلى الكوفة أنه كان حملهم على أقتاب الإبل دون وطاء([437]).
ويروي شاهد عيان آخر ـ يُدعى جديلة الأسدي([438]) ـ دخول السبايا إلى الكوفة بقوله: «كنت في الكوفة سنة قتل الحسين، فرأيت نساء أهل الكوفة وهنّ مشقّقات الجيوب، ناشرات الشعور، لاطِمات الخدود، فأقبلت إلى شيخ كبير وقلت له: ما هذا البكاء والنحيب؟ فقال: من أجل رأس الحسين، فبينما أنا كذلك واذا بالعسكر قد أقبل والسبايا معه، ثمّ أخذ أهل الكوفة يطعمون الأطفال بعض التمر والجوز، فصاحت أمّ كلثوم: إنّ الصدقة علينا حرام أهل البيت([439])، وجعلت تأخذه من أيدي الأطفال وترمي به، فضجّت النّاس بالبكاء والنحيب، فقالت أمّ كلثوم: تقتلنا رجالكم، وتبكينا نساؤكم، لقد تعديتم علينا عدواناً وظلماً عظيماً، جئتم شيئاً فرياً([440])، تكاد السماوات يتفطّرنَ، وتنشقّ الأرض، وتخرّ الجبال هدّاً»([441]). وفي رواية أخرى أنّ أطفال السبايا عندما قدّم لهم أهل الكوفة بعض التمر والخبز، رَمَوه من أيديهم وأفواههم حال سماعهم قول أمّ كلثوم بأنّ الصدقة محرّمة عليهم أهل البيت([442])، وبالرغم ممّا كانوا يعانونه من الجوع والعطش والتعب إلّا أنّهم لم يتعدّوا على حدود الله تعالى، ولم يخضعوا لأي أحد مهما قست عليهم الأيام.
وعندما أشرفت امرأة من الكوفيات من سطح دارها وهي تتفرّج على السبايا، وقد قيل لها: إنّهم من الخوارج، فسألتهم: «من أي الأسارى أنتنّ ؟ فقلنَ: نحن أسارى آل محمّد، فنزلت من سطح دارها، وجمعت ملاء([443])وأزرا ومقانع، وقدمته لهم ليتغطّوا به وأعطتهن فتغطين»([444])، وقد قبلن بهذا وأخذنه ليكون غطاءً وستراً لهنّ؛ لأنّه قد نُهِبت منهنّ كثير من ملابسهنّ وحاجياتهنّ يوم الطف.
ومن الصور التي كانت تُشاهد في الكوفة يوم دخول السبايا إليها، أنّ النّاس حيارى ويبكون، رافعين أيديهم إلى أفواههم من شدّة حيرة النّاس وصدمتهم وبكائهم، ويُروى أنّ هناك شيخاً كبيراً واقفاً يبكي حتى اخضلّت لحيته ويقول: «بأبي وأمّي كهولكم خير الكهول، وشبابكم خير الشباب، ونساؤكم خير النساء، ونسلكم خير النسل، لا يخزى ولا يبرى»([445]).
وقد وصف عدد من المؤرِّخين دخول سبايا آل البيت إلى الكوفة، فذكر اليعقوبي(ت292هـ/904م) دخول سبايا آل محمّد إلى الكوفة بقوله: «وحملوهنّ إلى الكوفة، فلمّا دخلنَ إليها خرجت نساء الكوفة يصرخنَ ويبكينَ، فقال علي بن الحسين: هؤلاء يبكينَ فمَن قتلنا؟!»([446]).
ويصف ابن أعثم الكوفي(ت314هـ/926م) دخول السبايا بقوله: «وساق القوم حُرم رسول الله من كربلاء كما تُساق الأسارى، حتى بلغوا بهم إلى الكوفة، خرج النّاس إليهم، فجعلوا يبكون وينوحون»([447]).
ويذكر الطوسي(ت460هـ/1067م) أنّه: «عندما جيء بالسبايا ومعهم الأجناد يحيطون بهم، وقد خرج النّاس للنظر إليهم، وقد أقبل بهم على الجمال بغير غطاء؛ أخذت نساء الكوفة يبكينَ ويندبنَ، فقال علي بن الحسين بصوت ضئيل وقد أنهكته العلّة وفي عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى عنقه: إنّ هؤلاء النسوة يبكينَ، فمَن قتلنا؟!»([448]).
ولعلّ هذا الأمر يشعر ببداية التغيّر الاجتماعي في السلوك الأخلاقي والسياسي لمجتمع الكوفة، من خلال تعاطفهم مع القضية الحسينية ورفضهم قتله. ويمكن تفسير ذلك على أنّ هذا الأمر لدى مجتمع الكوفة كان فكراً صنعته ثقافة معينة عكست واقعهم الذاتي، الأمر الذي أظهر عوائق هذا الفكر وتخلفه. فالأمويون زجّوا بنظرية سياسية بُنيت على أساس القهر والغلبة، فتولّدت أزمة في الخُلُق العربي الإسلامي، إذ كان مؤسس الدولة الأموية ـ معاوية ـ منكبّاً منذ بداية حكمه على التفنّن في زراعة الفتنة داخل المجتمع، وذلك من خلال الدعاية التحريضية ضد الإمام علي×، وأن التشيّع كحركة معارضة مقاومة يجب استئصالها([449]).
وممّا تقدّم يمكن القول أنّ خبر السبايا انتشر بين أهل الكوفة قبل وصولهم، ممّا أدّى إلى حدوث تجمّعات كبيرة للأهالي في شوارع الكوفة لاستقبال السبايا والتفرج عليهم، حيث فُرِض على السبايا التجوال في تلك الشوارع، وهذا ما كان يهدف إليه ابن زياد من التشهير بآل البيت^والتشفّي بهم. ويُلمس ذلك من خلال الاستعراض العسكري الذي أعَدَّه عند دخول السبايا إلى الكوفة، وكأنه انتصار على أعداء الإسلام والمسلمين، وأنّه جاء بسباياهم.
ثمّ إنّ أهل الكوفة كانوا منقسمين في موقفهم، ما بين مؤيّد للسلطة الأموية ويبدو عليه الفرح علناً ويتبادل التهاني مع الآخرين، وقد انضمّ مع أصحاب هذا الموقف مَن كان جاهلاً بما حدث، وبين مَن كان معارضاً للسلطة يبكي سرّاً ونساؤه يبكين علناً، ولا حيلة له في اتّخاذ موقف ما؛ لما نشره ابن زياد من الخوف والرعب بين أهالي الكوفة.
خطبة السيّدة زينب بنت علي بن أبي طالب÷ في أهل الكوفة
إنّ الدور الذي قُمنَ به بنات الرسالة المحمدية، وهنّ سبايا بعد قتل الإمام الحسين× دور إعلامي مهمّ، مع ما كان فيهن من عظم الفاجعة والألم، بحيث تمكنّ دورهم هذا من فضح سلطة بني أميّة في الكوفة وفي دمشق على التوالي في توعيّة النّاس وتعريفهم بحقائق الأحداث، وإنّهم آل البيت لا خوارج كما يتردّد في دعاية إعلام بني أميّة، وأبرزنَ الهدف الذي من أجله ثار الإمام الحسين×، وفضحنَ أعمال بني أميّة الشنيعة في إساءتهم لذريّة الرسول’ في قتل أولاده وأهل بيته، وسبي عياله وانتهاك حرماته.
ومن اللواتي قُمنَ بهذا الدور البطولي السيّدة زينب، والسيّدة أمّ كلثوم بنتا الإمام علي بن أبي طالب، والسيّدة فاطمة بنت الحسين^، وكانت أقدرهنّ السيّدة زينب بنت علي بن أبي طالب‘في أداء هذا الدور الريادي برباطة جأش، وهي ثكلى قد فقدت ابنها، وأبناء أخوتها وأخواتها، وبني عمومتها، فضلاً عن إخوتها، وفي مقدّمتهم سيّد البيت العلوي، أخوها الإمام الحسين بن علي÷، وقد ذُبِحوا أمام ناظريها([450])، تجلس عند أوصالهم المقطّعة وتقول: «اللهمّ تقبّل منّا هذه القرابين»([451]).
وقبل أن نتناول خطبة السيّدة زينب بنت علي÷ لا بدّ من الحديث بإيجاز عن أهمّ محطّات حياتها، وأهمّ ما في ذلك أنّها ضربت المثل الأعلى في الصبر على المصاب، والثّقة بالله تعالى في مواطن البلاء، وجسّدت معاني ومفاهيم الإسلام السامية، فألجمت تلك الأسيرة أفواهَ أولئك الطغاة المجرمين بحجر، لم يتمكّنوا بعدها من الدفاع عن أنفسهم، وإقناع النّاس بصحة ما قاموا به عمل شنيع للدفاع عن دولتهم،فهي في ضعفها ووحدتها أعظم قوّة ممَّن أسرها، بدّدت أكاذيبهم، وحافظت على نسل بيت النبوّة من الزوال، فهذه الروح الجهادية لازمتها في حياة أبيّها وأخويّها، ولا سيما في معركة الطفّ([452]).
السيّدة زينب هي بنت علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمية القرشية([453])، وأمّها فاطمة بنت محمّد رسول الله’([454])، وأشقّاؤها الإمامان الحسن والحسين÷ والمحسن وأمّ كلثوم([455])، ولها عدد من الإخوة والأخوات من أمّهات شتّى، فإضافةً إلى أشقّائها بلغ عدد إخوتها أربعة عشر أخاً، وعدد أخواتها الإناث سبع عشرة أو تسع عشرة أختاً([456]).
أمّا كنيتها، فقد كُنيّت بأمّ كلثوم، وقد تسبّبت هذه الكنية في أن يقع كثير من المؤرِّخين في وهم بين السيّدة زينب‘ وأخواتها الأخريات المسميّات بأمّ كلثوم، فالأولى أمّ كلثوم الكبرى، وهي أصغر من السيّدة زينب‘، وأمّهما فاطمة بنت الرسول÷([457])، وأمّ كلثوم الوسطى، وهي من زوجة أخرى لعلي، وقد تزوّجت من ابن عمّها مسلم بن عقيل([458])، وأمّ كلثوم الصغرى، وهي من زوجة أخرى لعلي أيضا، وقد تزوّجت من عبد الله الأكبر بن محمّد بن عقيل([459]).
لم تُشر المصادر إلى سنة ولادة السيّدة زينب‘ بالتحديد، وإنّما ذكرت أنّها وُلِدت في حياة جدّها([460])، كما أنّ الباحثين لم يتّفقوا أيضاً على سنة ولادتها‘، فأشار أحدهم إلى أنّها كانت في عام 4هـ/625م([461])، وأشار آخر إلى عام 5هـ/626م([462])، أو إلى شعبان من عام 6هـ/627م([463])، أو إلى عام 9هـ/630م([464])، ويبدو أنّ القول الأخير لا يقارب الصحّة؛ فإذا كانت ولادتها في السنة التاسعة للهجرة وتُوفّي الرسول’ في السنة الحادية عشرة للهجرة([465])، وتُوفّيت أمّها بعد الرسول’ بستة أشهر على إحدى الروايات([466])، فكيف تكون زينب كبرى بنات السيّدة فاطمة‘، كما صرّح بذلك أغلب المؤرخين؟! فمتى كانت ولادة أم كلثوم؟! ومتى حملت بالمحسن؟! وإذا غضضنا النظر عمّا تقدّم، مع ذلك فإنّنا نعتقد أنّ السنة الخامسة للهجرة هي الأقرب إلى الصحّة؛ لكي تستطيع السيّدة زينب أن تروي لنا خطبة فاطمة الزهراء‘ بعد وفاة الرسول’([467]).
وقد زوّج الإمام علي بن أبي طالب× ابنته زينب‘ من ابن عمّها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب([468]). الذي لم يكن مع ابن عمّه الإمام الحسين× في الطفّ؛ وذلك لفقدان بصره([469])، وتُوفّي عام 80هـ/699م([470])، وكان عمره يومئذ تسعين سنة([471]).
وقد اختُلِفَ في عدد الأولاد الذين أنجبتهم السيّدة زينب‘لعبد الله، فذكر ابن سعد بأنّهم: علي وعون وعباس ومحمّد وأمّ كلثوم([472])، وذكر الطبرسي أنّهم: علي وجعفر وعون وأمّ كلثوم([473])، وذكر الديار بكري: أنّهم علي وعون وعباس وأمّ كلثوم([474])، وذكر النووي: أنّهم جعفر الأكبر وعلي وعون الأكبر وعباس وأمّ كلثوم([475]).
ويبدو أنّ اختلاف المصنّفين في عدد أولاد السيّدة زينب‘ يعود إلى تشابه أسمائهم مع أسماء إخوتهم من زوجات أبيهم الأخريات. وإنّ عون قُتِل مع خاله الإمام الحسين× في الطفّ، ومحمّد الذي قُتِل مع أخيه في المعركة نفسها فهو من زوجة أخرى لعبد الله بن جعفر، تُدعى الخوصاء بنت حفصة، من بني بكر بن وائل([476]).
لقد نشأت السيّدة زينب‘وترعرعت في بيت النبوّة والوحي، فهي من أسرة تنتهِي إليها كلّ المكارم والفضائل، فهم أولّ النّاس إسلاماً، وهم المجاهدون لإعلاء كلمة الله تعالى، وقد عاشت السيّدة زينب‘عاشت مع جدها رسول الله’ وأمّها السيّدة فاطمة الزهراء‘ خمس سنوات، وما يقارب الثلاثين سنة مع أبيها، ومعظم عمرها مع أخويها الحسن والحسين÷، فتغذّت منهم روحياً.
وأمّا ما يدلّ على غزارة علمها، فقد كان لها مجلس في بيتها أيّام وجودها في الكوفة، تفسّر فيه القرآن الكريم للنساء([477])، وعنها رُويت خطبة أمّها فاطمة‘، التي احتجّت بها حول نحلتها فدك([478]) التي أنحلها لها أبوها الرسول’ عند منعها من حقّها فيها([479]). وقد روى هذه الخطبة عن زينب‘ عبدُ الله بن عباس([480]).
المتتبّع في حياة وسيرة السيّدة زينب‘ يجد أنّها لم تتمتع يوماً في حياتها بمباهج الدنيا وزخرفها، ولم تشعر أنّها في بيئة مطمئنة([481])، وأنّها تحمّلت مقداراً من ثقل الإمامة أيّام مرض ابن أخيها الإمام علي السجّاد×، إذ إنّ الإمام الحسين× أوصى به إليها بجملة من وصاياه([482]).
كما تعدّدت الروايات التاريخية أيضاً في السنة التي تُوفِّيت فيها السيّدة زينب‘ وفي مدفنها، فأشارت إلى أنّ وفاتها في الخامس عشر من رجب سنة 62هـ/ 681م([483])، ومن الباحثين مَن أشار إلى أنّها قد دُفِنت في سنة 65هـ/683م([484])، وقد ذُكِرت أماكن متعدّدة لمدفنها، حيث قيل: في سنجار، ودمشق، ومصر، والمدينة المنوّرة([485]).
ويبدو أنّ شهرة السيّدة زينب‘جاءت من خلال تحمّلها المسؤولية الكبرى إبّان أحداث معركة الطفّ وما بعدها في الكوفة والشام، وأيّ مسؤولية لها نريد التحدّث عنها؟! وهل تستوعبها القلوب والعقول؟! فقد نجحت بالقيام بمسؤوليتها بالرغم من المآسي التي عاشتها.
ولمعرفة ذلك ما علينا إلا أن نتخيّل صورة يوم العاشر من المحرّم، من جهات متعدّدة وأبعاد مختلفة، فالحسين× مجزّر، وإخوته وأبناؤه وأبناء عمومته وأنصاره كالأضاحي على الأرض في البيداء، وكانت هذه الأجساد الطاهرة على بعد خطوات، وعلى مرمى العين من مخيّم النساء والأطفال، ولم يسلم هذا المخيّم من الحرق بعد أن نهب ما كان فيه من متاع، وسلب النساء حليهنّ وحاجياتهنّ، وفرار الأطفال اليتامى على وجوههم وهم عطاشى حيارى، لا يدرون أيّ جهة ستؤويهم، وصياح جيش ابن سعد وصهيل خيوله وأبواقه المخيفة تملؤ المكان. ثمّ جاء ليل الحادي عشر، وهي أقسى وأثقل وأطول ليلة مرّت على السيّدة زينب‘ومَن معها، حيث لا حماة من أهلها، يحيطون بهم الأعداء من جند ابن سعد.
أمام هذه الصورة المرعبة ابتدأ الدور الفعليّ للسيّدة زينب‘، حيث أمامها مهمتان:
الأولى: المحافظة على الإمام السجّاد، وعلى الحُرم والأطفال، فسارعت إلى جمع مَن تفرّق منهم بعد حرق الخيام، وباتت تلك الليلة ومعها بعض أخواتها لحراسة ومداراة الحُرم والأطفال.
الثانية: وهي الأشقّ والأصعب، وهي مسؤولية حمل الرسالة؛ إذ عليها أن تقوم بفضح الجرائم التي أرتكبها الأمويون في قتلهم الحسين وإخوته وأبنائه وأنصاره، وسبي أهل بيته، واستكمال مجريات الثورة الحسينية، وكان ذلك من خلال خطبها، سواء أكان في الكوفة أم الشام([486])، تلك الخُطب التي أجّجت الرأي العام بعد أن أوضحت له الصورة بشكل جليّ، وصار بنو أميّة وأعوانهم في خزي وعار أمام النّاس بعد أن عرّتهم وكشفت انتهاكاتهم للحرمات، وبيان مدى الإساءة لذرية النبي’ بقتل أولاده من أهل بيته^، وسبي عياله.
إنّ خطاب السيّدة زينب بنت علي÷ في حشود أهل الكوفة، الذين كانوا يتفرّجون على سبايا أهل البيت^، اللائي يتجوّل بهنّ شرطة ابن زياد في شوارع المدينة، يعدّ هذا الخطاب أول تصريح يصدر عن أهل البيت^ عن معركة الطفّ بعد حدوثها، كما مثّل أول تحدٍّ من قِبَل السيّدة زينب‘، حيث اتّسم بقوّة البيان وصلابة الإيمان بوجه أعداء أهل البيت، وهي تلي أمّها في الفضائل وأباها في المعرفة.
لقد تحمّلت السيّدة زينب مسؤولية الاستمرار في نشر أهداف الثورة الحسينية، وتعرية الحكم الأموي وتسلّطه، وتحطيم الدعاية الإعلامية التي كانوا قد نشروها، وكشف الحقائق أمام النّاس وتوضيحها لهم، على أنّ الذين تمّ قتلهم وسبيهم هم ليسوا من الخوارج، وإنّما هم آل بيت النبوّة. وقد عبّر خطابها عن رأي آل البيت في معركة الطفّ بعد حدوثها، متضمّنا لوم مجتمع الكوفة الذي كان سبباً في وقوع هذه المأساة التي أصابت أهل البيت^.
لقد شبّه بشير بن خزيم الأسدي ـ وهو من فصحاء العرب ـ خطبة السيّدة زينب‘ في أهل الكوفة([487])، بعد أن أخذه العجب من بلاغتها وفصاحتها؛ ببلاغة الإمام علي بن أبي طالب×، في الأسلوب والبيان والمستوى، «فهو مشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه ظهر مكنونها، وعنه أخذت قوانينها، وعلى أمثلتها حذا كلّ قائل خطيب، وبكلامه استعان كلّ واعظ بليغ»([488])، حيث قال بشير في حقّها: «ولم أر خَفِرة([489])والله أنطق منها، كأنّها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقد أومأت إلى النّاس أنِ اسكتوا، فارتدّت الأنفس([490])، وسكنت([491]) الأجراس»([492]). ويتبيّن من كلام بشير بن خزيم بأنّها أقوى على التكلّم، وأقدر على الخطابة، رغم أنّها شديدة الحياء، وقد سترت وجهها عن مَن تكلّمهم مع ما أصابها من مصائب، ورغم أنّها لم تخاطب الرجال، ولم تلقِ أي خطبة في جمعٍ ما من قبل، ولكن مع ذلك فقد تمكّنت من تحطيم جدار الخوف، واستطاعت أن تلقي خطبتها أمام جموع أهل الكوفة دون أن تتلعثم أو تتلكّأ، وهذا هو الذي جعل بشير بن خزيم يندهش من براعتها وشجاعتها الأدبية.
لقد كانت الظروف المحيطة بسبايا آل البيت في
الكوفة صعبة جداً،
حيث تجمّعات النّاس المتفرّجين عليهم من جهة، واحاطتهم بحراسات مشدّدة
من قِبَل أفراد شرطة ابن زياد من جهة أخرى، إلّا أنّه مع ذلك كله نجد أنّ السيّدة
زينب‘كانت صلبة، وبإشارة واحدة ـ وبتلك الروح القوية التي استولت على الموقف ـ إلى
جموع النّاس بالسكوت؛ فَساد الهدوء والصمت، وافتتحت كلامها بالثناء على الله
تعالى، والصلاة على الرسول’ واصفة إيّاه بأنّه أبوها؛ لتذكّر النّاس بأنّ الذين
تمّ قتلهم وسبي عيالهم هم أحفاد رسول الله’. ثمّ إنّ قولها: «أمّا
بعد: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل([493])والغدر([494])؟ أتبكون؟
فلا رقأت([495])الدمعة،
ولا هدأت الرنّة([496])، إنّما مَثلكم
كمَثل التي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً([497])، تتّخذون
أيمانكم دخلا([498])بينكم،
ألا وهل فيكم إلّا الصَّلَف([499])النطف([500])، والصدر
الشَّنَف([501])، ومَلَقُ([502])الإماء،
وغمز([503])الأعداء،
أو كمرعى على دِمنَة([504])، أو كفضّة على
ملحودة، ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسكم، أن سَخِط الله عليكم، وفي العذاب أنتم
خالدون»([505])ونجد ـ كما
أشار أحد الباحثين المحدثين ـ في هذه الفقرة من خطبتها جانبين:
الجانب الأول: تحميل المجتمع الكوفي المسؤولية المباشرة عمّا حدث للإمام الحسين× وأهل بيته^.
الجانب الثاني: توضيح مساوئ أهل الكوفة، وما يتمتّعون به من أخلاق وعادات سيئة، كإنكارهم للعهود، وعدم مراعاتهم للأيمان التي قطعوها على أنفسهم من خلال مكاتباتهم للإمام الحسين×، ووفودهم التي أرسلوها إليه وهو في مكّة([506])، يلحّون فيها بقدومه عليهم إلى الكوفة، وعندما أرسل إليهم الإمام الحسين× رسوله وابن عمّه وثقته من أهل بيته مسلم بن عقيل× بايعوه، ومن ثمّ خذلوه وأسلموه حتى قتله ابن زياد. وهذا عين ما فعلوه مع الإمام الحسين× أيضا، لأنّهم قد استسلموا بسهولة إلى مشاعر الخوف والتهديد والإرهاب الذي نشره ابن زياد في الكوفة، وعلى ذلك فإنّ صفة الغدر واضحة عند أهل الكوفة، إذ إنّ الجيش ـ سواء كان قيادات وأفراداً ـ الذي زحف لقتال الإمام الحسين× في الطفّ كان من أهل الكوفة، ولم يشارك فيه أحد من جند الشام. والكثير ممَن لم يُشارك بالمعركة اكتفى بالتفرّج على سبايا أهل البيت^، ولم يستحوا من الله تعالى ورسوله’، فلماذا هذا الصمت وعدم المبالاة في كلّ ما يحدث حولهم؟ ولا نجد لهم أيّ ردّة فعل على ما جرى إلّا البكاء([507]).
لقد حمّلتْ السيّدة زينب‘ أهل الكوفة المسؤولية عن الفاجعة، لذلك وجهّت إليهم كلمات التوبيخ والتقريع والذمّ: «... يا أهل الختل والغدر... »، أنتم أهل الخداع والمراوغة، وأصحاب الخيانة ونقض العهد، فشبّهتهم بقولها: «إنّما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً»، وهذا التشبيه مشتقّ من القرآن الكريم، وفي الوقت نفسه يدلّ على مستوى رفيع للسيّدة زينب‘ في البلاغة والفصاحة، قال الله تعالى: (وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ)([508])، وجاء في كتب تفسير القرآن أنّ امرأة حمقاء من قريش كانت تغزل مع جواريها الصوف والشعر من الصباح إلى نصف النهار، تصنع من ذلك خيوطاً جاهزةً للنسيج، ثمّ تأمر جواريها بنقض ما تمّ غزله طوال هذا الوقت، ولا يزال دأبها في ذلك([509]). وقد استعملت السيّدة زينب‘ هذا المثل القرآني الكفيل بتأجيج روح الندم والأسف لِما فرّطوا به، وأرادت أن تهزّ مشاعرهم للخطأ الجسيم الذي اقترفوه مع الإمام الحسين×([510]) بغدرهم وخيانتهم مع ما عندهم من القوّة التي أضاعوها بحماقتهم، فتجدهم يقفون في بادئ الأمر إلى جانب الحقّ، ويقدّمون في سبيله التضحيّات، لكنّهم سرعان ما يتراجعون وهم في ذروة الصراع مع الباطل، والنصر قريب منهم([511])، وإنّ مواقفهم في ذلك ما زالت شاخصة أمام أهل البيت^، وأول تلك المواقف هو موقفهم مع الإمام علي بن أبي طالب×، واستجابتهم السريعة لخديعة معاوية بن أبي سفيان برفعه المصاحف في معركة صفّين([512])، وثانيها مع الإمام الحسن بن علي÷؛ إذ بايعوه والتفّوا حوله لمواجهة معاوية، وعندما حان وقت المواجهة تخاذلوا عنه، وإنّ قسماً منهم انحاز إلى جانب معاوية طمعاً بالمال([513])، وثالثها ما كان مع الإمام الحسين×، وهذا ما أشرنا إليه آنفاً.
وقد أشارت السيّدة زينب‘ إلى أبرز الصفات السيّئة في مجتمع الكوفة فقالت: «وهل فيكم إلّا الصَّلَفالنطف، والصدر الشَّنَف، ومَلَقُالإماء، وغمزالأعداء، أو كمرعى على دِمنَة، أو كفضّة على ملحودة»، فإنّهم في حالة تكبر وإعجاب بالنفس، والتمدّح بما ليس في الذات، وتنطفّهم بالعيب، أو القذف بالفجور، والبغض والتنكّر، وتملّقهم كما تتملّق الأمة لسيّدها من أجل إرضائه. واتّصفوا بالغمز وهو العصر باليد، وهي صفة الضعف عند الرجال الجبناء، ولهذا كان قصدها ضعف أهل الكوفة لدرجة سهولة عصرهم، أي: إظهار ضعفهم أمام العدوّ، ومن معانيها اللين، ولهذا يُطلق على الرجل الضعيف الغَمَزُ، وكذلك تعني رذّال المال، أي: الذين يتودّدون للحكّام من أجل الحصول على منافع مالية منهم. والمرعى هو محلّ العشب الذي يسرح فيه القطيع، والدمنة هو المحلّ الذي تتراكم فيه أرواث الحيوانات وبولها، وتختلط مع التراب في مرابضهم، فتتماسك الأوساخ المتكوّنة من الروث والبول والتراب، وبسبب الرطوبة الموجودة ينبت هناك نبات أخضر جميل المنظر واللون، لكن الجذور نابتة في مكان وسخ ملئ بالجراثيم.
وهكذا وجدت السيّدة زينب‘ أهل الكوفة أنّ لهم ظاهراً حسناً، وباطنهم وواقعهم قبيح، يشتمل على الخبث والخديعة والخيانة والكذب والنفاق والجرأة على الله تعالى، وسحق القيم والمفاهيم، وعدم التحلّي بالفضائل، التي من أبرزها الوفاء بالعهد.
وقد شبّهت السيّدة زينب‘المجتمع الكوفي بذلك الرجل الذي يوضع على قبره قطعة بيضاء من الجصّ أو الفضّة وهو بعيد عن الدين، فيكون ظاهر القبر جميلاً، لكنّ الجثّة في داخل القبر جيفة متعفّنة، وتعني بذلك أنّ بياض الخارج لا يُغني عن سواد وقبح الداخل، وكذلك أهل الكوفة ظاهرهم زينة وباطنهم ضغينة.
ثم استمرت السيّدة زينب بخطبتها ـ كما ينقلها الطبرسي([514])ـ وذكرت معانِ مهمّة، حيث قالت: «أتبكون؟ وتنتحبون؟([515])، إي والله فابكوا كثيراً، واضحكوا قليلاً»، وبهذا تقول لهم: ابكوا كثيرا بأصوات عالية، وإنّ ضحككم بما حققّتموه سيكون قليلاً، وكلّه لا يُفيدكم، وإنّها إشارة لقوله تعالى:(فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)([516])، والمعنى: فليضحك هؤلاء المنافقون قليلاً؛ لأنّ الضحك حتى لو استمرّ فإنّه ينتهي بموت الأنسان، وهو قليل بالقياس مع بكائهم الدائم يوم القيامة، لأنّ ذلك (...يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)([517])، وهذا تهديد ووعيد وإنذار لهم.
وقولها: «فلقد ذهبتم([518])بعارها([519])وشنارها([520])، ولم ترحضوها([521])بغسل بعدها أبداً، وأنّى ترحضون قتل سليل خاتم النبوّة، ومعدن الرسالة، وسيّد شباب أهل الجنّة »([522])، إنّها الدقّة في تصوير المعنى، أي أنّهم صحبوا كلّ شيء يلزم منه عيب، أو كلّ ما يُعيَّر به الأنسان من قول أو فعل، فتقول لهم أنّه قد لزمكم العار، وستبقى أفعالكم الشنيعة مصاحبة لكم، ولا غسل يبرّؤكم منها، فجريمتكم ليست ثوبا لتغسلوه، ويسقط ما تعلّق به من نجاسة مكروهة، لكن كيف تغسلون وتمحون وتمسحون عن أنفسكم وصحيفتكم آثار هذه الفاجعة العظيمة، التي تبعدكم عن رحمة الله تعالى باعتدائكم على رسول الله’ خاتم الأنبياء، وقتلكم سبطه وحبيبه الإمام الحسين×، وسبيكم عياله وثقله وهم حُرَم الرسول’، فهل هناك مجال للإعتذار بارتكاب جريمة بهذا الحجم ومع تلكم الكيفية؟!
وقولها: «وملاذ([523])خيرتكم([524])، ومفزع([525])نازلتكم([526])، ومنار حجّتكم،
ومدرة([527])سنّتكم،
ألا ساء ما تزرون، وبعداً وسحقاً([528])، فلقد خاب
السعي، وتبّت([529])الأيدي،
وخسـرت الصفقة([530])، وبؤتم([531])بغضب من
الله، وضربت عليكم الذلّة والمسكنة»([532])، فتريد أن تقول: الذي قتلتموه هو الملجأ
والحصن الآمن الذي يُحتمي به، ويلجأ إليه الخيّرون في الشدائد، وهم المؤمنون
الأبرار، وهو الذي يفزع لهم وبكلّ ما أوتي في شدائد الدهر التي تنزل بالقوم، أفمثل
هذا يُقتل؟!
وقولها: «ويلكم([533])يا أهل الكوفة، أتدرون أيّ كبد لرسول الله فريتم؟ ([534])، وأيّ كريمة له أبرزتم؟ وأيّ دم له سفكتم؟ وأيّ حرمة له انتهكتم؟»([535])، لقد وعدتهم السيّدة زينب‘ بالعذاب الشديد؛ لقتلهم الإمام الحسين× وهو ابن رسول الله، والكبد كناية عن الولد([536]) ـ وقد رُوي عن الرسول’ قوله: «أولادنا أكبادنا»([537]) ـ ولم يكن قتله اعتيادياً كما يجري في معارك شتّى، بل قطّعوا جسده إرباً إرباً. وقد شبّهت السيّدة زينب‘ الإمام الحسين× بكبد رسول الله’، وشبّهت جريمة قتله بقطع كبد الرسول’، وكم يحمل هذا التشبيه في طياته من معاني بلاغية وحقائق روحانية، والثابت أنّ مكانة الكبد في الجسم لها وظائف مهمّة جداً، فكم يبلغ الانحراف لِمَن يدّعي أنّه مسلم ويقتل شخصاً هو بمنزلة الكبد من رسول الله تعالى.
وقولها: «لقد جئتم بها صلعاء([538])عنقاء([539])سوداء فقماء([540])خرقاء([541])شوهاء([542])، كطلاع الأرض([543])، أو كملاء السماء»([544])، فإنّها قد وظّفت المفردات لمعانٍ مقصودة، وذلك لمواجهة خطة بني أميّة وأعوانهم، حيث جسّدت السيّدة زينب الواقع ورسمته بوضوح، فكان لصدى كلماتها الأثر البالغ لتصوير حجم الفاجعة، وذلك من خلال إتيانها بصفات متتالية، حاكيّة عن الحالة المعبّرة عنها الواحدة تلو الأخرى، من دون فصل؛ لتبقى تتردّد في أذهان السامعين، عاكسةً لهم الدلالة الواقعية([545])، التي أحدثت توافقاً صوتيّاً في إثارة أفق فنّي لاستيعاب الدلالة للجريمة التي ارتكبوها، التي لا يمكن تغطيتها في معنى حجم أو مساحة معينينِ، بل هي بحجم الأرض كلّها، والسماء والفضاء كليهما، أي أنّ حجمها أكبر من أن يتصور.
ثم قالت: «أفعجبتم أن تمطر السماء دماً، ولَعذاب الآخرة أخزى، وأنتم لا تُنصرون»([546])، وفي قولها هذا إشارة إلى بعض الظواهر الكونية الغريبة التي حدثت عند قتل الإمام الحسين×، حيث مطرت السماء أيّاماً دماً([547])، وهذا خبر حقيقي شاهدته السيّدة زينب‘ وأخبرت به؛ ليخلّده التاريخ، وتذكره الأجيال جيلاً بعد جيل. وقيل أيضاً: إنّه عند مقتل الإمام الحسين× ظهرت حُمرة في السماء لم يُرَ مثلها من قبل.
وأشار هنا سبط بن الجوزي([548])، نقلاً عن جدّه عبد الرحمن بن الجوزي، وهو حنبليُّ المذهب، مفسّراً حُمرة السماء عند قتل الحسين× بأنّ الغضبان يحمرّ وجهه عند الغضب، فيستدلّ من ذلك على غضب الله تعالى، وأنّه أمارة سخطه، فبما أنّ الله تعالى ليس بجسم فظهر تأثير غضبه على مَن قتل الحسين بحُمرة الأفق، وذلك دليل على عظم الجناية.
كما أنّه كلّما رُفِع حجر في القدس والشام يوم قتل الإمام الحسين× وُجِد تحته دم عبيط([549])، وشُوهِدت الحيطان تسيل دماً. وقيل: لمّا قُتِل الإمام الحسين× مكث النّاس شهرين أو ثلاثة كأنّ الحيطان لُطّخت بالدم من طلوع الشمس حتى ترتفع([550]). وقيل: إحمرّتْ آفاق السماء بعد قتل الإمام الحسين× ستّة أشهر، يُرى فيها كالدم، وانكسفت الشمس، واسودّت السماء، وظهرت الكواكب نهاراً([551])، فويل للذينَ قتلوا الإمام الحسين×، ولهم عذاب وخزي عظيمان في الآخرة، ولن ينصرهم أويشفع لهم أحد.
وفي نهاية خطابها كان هناك إنذار بالانتقام؛ لأنّ عدالة الله تعالى تأبى أن تمرّ تلك الجريمة دون عقاب يتناسب مع حجمها وخطورتها، إمّا أن يكون العقاب حالاً أو بعد حين، حيث قالت: «فلا يستخفنّكم المهل([552])، فإنّه لا يحفزه([553])البدار([554])، ولا يخاف فوت([555])الثأر([556])، وإنّ ربكم لبالمرصاد»، أي: لا تستخفّون بالمهلة، فإنّ الإسراع في الأخذ بدماء القتلى قريب عند الله تعالى، فالانتقام الإلهي من قتلة الإمام الحسين×شديد وإن أتى بعد مدّة وبدون عجلة، وإنّ دم الإمام الحسين× هو ثأر الله تعالى وابن ثأره([557])، فلا بدّ من أخذه.
وبهذا فإنّ السيّدة زينب‘ كشفت الحقائق، واستشرفت رؤيا مستقبلية، طبقاً لأحكام إلهية وأمور عقلية أخذتها عن جدّها وأبيها وأمّها وأخوَيها^، فقد ذكّرت النّاس بآيات من القرآن الكريم ليرجعوا إلى معانيها وأحداثها ويتدبّروها، وسيجدون ما ينتظرهم من وعيد الله تعالى وعذابه الشديد، وهذه الآيات هي: أول آية في سورة النحل، وآخر سورة (ص)، أمّا الآية الأولى فهي قوله تعالى: (َتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)([558])، روي عن النبي’ أنه عندما نزل جبريل بهذه الآية من سورة النحل، وبدأ بقراءتها فزع النبي’، ونهض من أمر الله تعالى الآتي، ولم يهدأ إلّا عند سماعه: (فلا تستعجلوه)([559])، وقد أعطى المفسرون معنى: (أمر الله تعالى) في هذه الآية بأنه له معان متعدّدة، منها: هو يوم القيامة، وهو قريب فيه عذاب شديد للكفّار والمشركين([560])، ومن معانيه الأخرى نصر النبي محمّد’ على المشركين والكفّار، وهو واقع لا محالة([561]). وأمّا الآية التي جاءت في آخر سورة (ص) فهي قوله تعالى: (وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ)([562])، وقد جاء الكلام تهديداً موجهاً إلى المشركين من قريش وغيرهم، بأنّ عليهم وجوب العلم بأخبار هذا القرآن، بما فيه من الوعد للمؤمنين والوعيد للمشركين ولو بعد حين ـ أي بعد الموت ـ وستأتي الآخرة، وعند الموت يأتيك الخبر اليقين يا ابن آدم([563]).
وفي هذا الحال الذي تتكلّم فيه السيّدة زينب‘ هاج النّاس وضجّوا بالبكاء، وبُهِتوا وظلّوا في حيرة من أمرهم، لا يعرفون ما يفعلون، وبدت خشية شرطة ابن زياد من هياج النّاس، وربما تطوّرالأمر إلى ما لا تُحمد عقباه، فرفعوا رؤوس القتلى أمام السيّدة زينب، فتوقّفت عن الكلام عند رؤية رأس أخيها الإمام الحسين× وضربت برأسها مقدّمة المحمل، وسال الدم من تحت مقنعتها([564])، ومسحته بخرقة كانت بيدها([565]). إنّ رواية ضرب السيّدة زينب لرأسها بمقدّمة المحمل هي محلّ نظر وتأمّل، إذ لا يمكن ذلك، فإن حدث فهو مخالف لوصية الإمام الحسين بن علي÷ لأخته السيّدة زينب‘ ليلة العاشر من المحرّم([566])، ولم يرد عنها مخالفة لوصية أخيها الإمام الحسين×، كما أنّ ذكر المحامل والهوادج لم يرد ذكره في غير خبر مسلم الجصّاص، وسبق وأن أشرنا إلى هذا الأمر آنفاً، فضلاً عن أنّ السيّدة زينب‘ كانت تتمتّع بروح قوية مليئة بالإيمان والصبر على ما أصابها، ويبدو ذلك واضحاً في جوابها لابن زياد عندما سألها: كيف رأيت صنع الله بأخيك وأهل بيتك؟ فأجابته السيّدة زينب‘ بأنها ما رأت إلّا جميلاً([567]).
إنّ لبلاغة السيّدة زينب بنت علي بن أبي طالب÷ الخطابية أثر كبير عند النّاس، بحيث جعلتهم يضجّون بالبكاء، لأنّهم فزعوا من هول ما أسمعتهم، وبلغ فيهم الأسف في نفوسهم ما بلغه، واستطاعت من خلال هذه الخطبة أن تردّ على الأعداء بكلّ قوّة وشجاعة وحُسن سياسة، بعد أن وجدت أنّه لا فائدة من القوّة والسلاح، وذكّرت الأعداء بآثامهم وخطاياهم، وأنذرتهم بعذاب الله تعالى، بتقريع شديد، وتأديب بالغ([568]). فالخطاب عند السيّدة زينب‘ يحمل بُعداً سياسياً في جوهرهِ لإقرار الحقّ الشرعي في الخلافة، ولا يقف عند حدود الذمّ لمجتمع الكوفة أو التمجيد والمدح لآل البيت، وإنّما يسعى لإقرار الحقّ الشرعي في الخلافة وأوّليتهم على غيرهم.
وأخيراً يصف بشير بن خزيم النّاس بعد إكمال السيّدة زينب‘ خطبتها «بأنّهم حيارى يبكون، وقد وضعوا أيديهم في أفواههم»، وكان ذلك بسبب الأثر البالغ الذي تركته الخطبة في نفوسهم، فضلاً عن أنّها جعلت بعضهم يشعر بالندم لعدم نصرته للإمام الحسين×، وبعضهم الآخر لاتّباعهم أوامر ابن زياد، وشعورهم بفداحة الجريمة التي ارتكبوها لقتلهم الإمام الحسين×.
فالوضوح والبلاغة والارتجال والتأثير هي من الصور التي تجلّت في أسلوب السيّدة زينب‘، وذلك من أجل إرساء الحقائق، وتشخيص العلاقة مع الآخر أو تقويمها. وهذا الحجاج أو الخطاب هو لإثبات الدعوى، وليس فقط في فعل إلقاء الحجّة على المخاطَب، بل النظر أيضا في فعل المتلقّي ليبني أدلّته، ويستكشف أمورها، ويقبل ويقتنع بالدليل([569]).
خطبة السيّدة فاطمة بنت الحسين ÷ على أهل الكوفة
كانت السيّدة فاطمة من النساء اللائي نهضنَ بدور كبير في الإعلام الحسيني، فأبوها الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب÷، وأمّها أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله التيمي([570])، التي تزوّجها الإمام الحسين× بعد وفاة الإمام الحسن× عنها، فولدت للإمام الحسين× فاطمة([571])، ولم تذكر سنة ولادتها، وقد سمّاها الإمام الحسين× بهذا الاسم على اسم أمّه السيّدة فاطمة بنت الرسول’، وكنيتها أمّ عبد الله، أو أمّ سلمة([572])، وإخوتها هم: علي الأكبر، وعلي الأصغر (السجّاد)، وجعفر، وعبد الله الرضيع، وسكينة([573]).
وكان لفاطمة مكانة عند أبيها؛ لشخصيتها القوية ورجاحة عقلها، ممّا جعل الإمام الحسين× يوم عاشوراء ـ وهو في ظلّ ذلك الظرف العصيب ـ يسلّمها وصيته، التي سلّمتها إلى أخيها الإمام علي السجّاد× فيما بعد عند شفائه من مرضه([574])، وقد زوّج الإمام الحسين×ابنته فاطمة من ابن أخيه الحسن المثنّى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب^عندما سأل عمّه الزواج([575])، وكان الحسن المثنّى قد حضر مع عمّه يوم الطفّ، وشارك في المعركة، وقد أُسِر بعد أن جُرح عدّة جراحات وشفي منها في ما بعد، وقيل: بعد إصابته أخذه خاله أسماء بن خارجة الفزاري([576])، لأنّ أمّه كانت فزارية([577])، وتركه ابن سعد لهم([578]). وأنجبت فاطمة منه عبد الله المحض، والحسن المثلّث، وإبراهيم الغمر، وزينب، وأمّ كلثوم، وقد عرف هؤلاء الأولاد بالعلم والأدب([579]). وقد تُوفّي الحسن المثنى مسموماً في عام 96هـ/714م([580])، أو في عام 97هـ/715م([581])، وقيل: إنّ السيّدة فاطمة‘ كانت ترفض الزواج من بعده رغم أنّ خُطّابها كانوا من الأشراف([582]).
وتُوفّيت السيّدة فاطمة‘ في المدينة المنوّرة سنة 117هـ/735م، وهي نفس السنة التي تُوفّيت فيها أختها سكينة، ودُفِنت في البقيع([583])، وأشارت بعض المراجع إلى أنّ وفاتها كان سنة 110هـ/728م، ودُفِنت في مصر([584]).
نجد ممّا تقدّم من سيرة حياة
السيّدة فاطمة‘ أنّها ذات شخصية قوية مسلّحة بالإيمان والصبر، والرضا بقضاء الله
تعالى وقدره، يمكن الاعتماد عليها في ملمّات الدهر ـ وما أكثر هذه الملمّات عند
أهل البيت^ ـ لتثبت جدارة أمام أعداء أهل بيتها، ولا سيما إبّان أحداث معركة
الطفّ، فإنّها تعرّضت يوم العاشر من المحرّم 61هـ/680م إلى سلب خلخالين([585]) من
رجليها عندما دخل الجُند إلى الخيام، كما نزعوا الملاحف عن ظهور النساء، وكانوا
يبكون عند سلبهم، لمعرفتهم أنّهم يسلبون بنات رسول الله’([586])، وعند
سبيها وأهلها ووصولهم إلى الكوفة وطوافهم في شوارعها بين المتفرّجين عليهم؛ انبرت
وأجادت في أروع خطاب وجّهته في حشود أهل الكوفة بالرغم من صغر سنّها، وهذا ليس
مفاجئاّ؛ لأنّها من مدرسة أهل البيت^، فقالت: «الحمد لله عدد الرمل والحصى، وزنة
العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به، وأتوكّل عليه، وأشهد أن لا إله إلّا الله، وحده
لا شريك له، وأنّ محمّداّ عبده ورسوله، وأنّ ذريته ذُبِحوا بشط الفرات بغير ذحل([587]) ولا ترات([588])،
اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أفتري([589])عليك
الكذب، وأن أقول عليك خلاف ما أنزلت من أخذ العهود لوصيّه علي بن أبي طالب،
المسلوب حقّه، المقتول بغير ذنب، كما قُتِل ولده بالأمس في بيت من بيوت الله، في
معشر مسلمة بألسنتهم، تعساً([590])لرؤوسهم،
ما دفعت عنه ضيماً في حياته ولا عند مماته، حتى قبضته إليك، محمود النقيبة([591])، طيّب
العريكة([592])، معروف المناقب، مشهور([593])المذاهب([594])، لم تأخذه اللهمّ فيك لومة([595])لائم، ولا عذل([596])عاذل، هديته يا ربّ للإسلام
صغيراً، وحمدت مناقبه كبيراً، ولم يزل ناصحاً لك، ولرسولك صلواتك عليه وآله، حتى
قبضته إليك، زاهداً في الدنيا، غير حريص عليها، راغباً بالآخرة، مجاهداً لك في
سبيلك، رضيته فاخترته، وهديته إلى صراط مستقيم.
أمّا بعدُ..
يا أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء([597])، فإنّا أهل بيت ابتلانا الله بكم، وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسناً، وجعل علمه عندنا، وفهمه لدينا، فنحن عيبة([598])علمه، ووعاء فقهه وحكمته، وحجّته على أهل الأرض في بلاده لعباده، وأكرمنا الله بكرامته، وفضّلنا الله بنبيّه محمّد، على كثير ممّن خلق تفضيلاً بيّناً، فكذّبتمونا وكفّرتمونا، ورأيتم قتالنا حلالاً، وأموالنا نهباً، كأنّنا أولاد ترك أو ديلم، قتلتم جدّنا بالأمس، وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت، لحقد متقدّم، قرّت بذلك عيونكم، وفرحت قلوبكم، افتراء على الله، ومكراً مكرتم، والله خير الماكرين. فلا تدعونّكم أنفسكم إلى الجذل([599])بما أصبتم من دمائنا، ونالت أيديكم من أموالنا، فيما أصابنا من المصائب الجليلة، والرزايا العظيمة، (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ)([600])، فتبّاً([601])لكم يا أهل الكوفة، أيَّ تراتٍ لرسول الله’ قبلكم؟ وذحول له لديكم، بما عنتّم([602])بأخيه علي بن أبي طالب جدي وببنيه وعترة النبي الأخيار (صلوات الله وسلامه عليهم)؟ وافتخر بذلك مفتخركم وقال:
|
نحن قتلنا علياً وبني علي |
بفيك أيّها القائل الكثكث([603])والاثلب([604])، افتخرت بقتل قوم زكّاهم الله وأذهب عنهم الرجس، وطهّرهم تطهيرا، فأكظم([605])وأقعى كما أقعى([606])أبوك (فإنّما لكلّ مرئ ما اكتسب وما قدمت يداه) أحسدتمونا ويلاً لكم على ما فضلنا الله: (ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ)([607])، (...وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ)»([608]). وارتفعت الأصوات بالبكاء وقالوا: «حسبكِ يا بنت الطيّبين، فقد أحرقتِ قلوبنا، وانتضحت([609])نحورنا، وأضرمت أجوافنا»، فسكتت وتركت أهل الكوفة في محنتهم ومشقّتهم([610]).
إنّ الذي يقرأ خطبة السيّدة فاطمة بنت الحسين÷ في أهل الكوفة، وينظر في كلامها الذي قالته فيهم، ويتمعّن في ألفاظها ومعانيها علمَ محلّها من الفصاحة والبلاغة، وحُسُن السبك والبراعة والعذوبة وجزالة القول وبعد المغزى؛ لأنّها من مدرسة أهل البيت الذين اتّصفوا في خطبهم بالصفات آنفة الذكر. فابتدأت كلامها بحمد الله والثناء عليه، والإقرار بالشهادتين.
ومن ثمّ بيّنت السيّدة أنّ الذين قُتِلوا في معركة الطفّ هم أبناء رسول الله’ وأحفاده، وأنصار الإمام الحسين×، حيث قُتِلوا عطاشا والفرات على بعد خطوات منهم، لحقد دفين على أهل البيت^، إنّها أحقاد جاهلية وأضغان بدرية، وقد قُتل الإمام الحسين×، وداست الخيل بدنه الشريف، فكشفت الصورة الوحشية لأفعالهم.
وبعد ذلك انتقلت في حديثها إلى سيرة جدّها الإمام علي بن أبي طالب× منذ إسلامه صغيراً، وهو محمود في أفعاله، ومعروف في فضائله، وطيب في طبيعته، وواضح في معتقده، ولم تأخذه لومة لائم في الحقّ والثبات عليه، ولم يتمكّن رادع يردعه عن ذلك، ولا يزال ناصحاً مجاهداً لله تعالى ورسوله، وقد سُلِب حقّه، وقُتِل بغير ذنب بين جماعة من المسلمين، فكان خسراناً لما يفكرون به، فلم يدفعوا عنه ضيماً في حياته، ولا عند مماته، أي أنّهم في حياته لم يعطوه حقّه والحماية والدفاع، وكذلك بعد وفاته، حيث تعرّض للسبّ والشتم ولم يدافعوا عنه، الامام علي الذي زهُد في الدنيا، ولم يكن حريصا عليها، بل كانت رغبته في الآخرة مجاوراً لربه.
وأمّا قولها لأهل الكوفة:«يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإنّا أهل بيت ابتلانا الله بكم، وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسناً، وجعل علمه عندنا وفهمه لدينا، فنحن عيبة علمه، ووعاء فقهه وحكمته وحجته...»، فإنّ محاسن هذا الكلام لا تُعدّ ولا تُحصى، فهي تذكر صفات سيئة لأهل الكوفة، مقابل صفات حسنة لأهل البيت^، فأهل الكوفة هم أهل مكر وخداع وغدر وتكبّر وعجب بالنفس، وأهل البيت^ هم أهل فهم، ومستودع علم الله تعالى، وحجته على النّاس، وذوو حكمة وفقه وكرامة، وإنّ بلاء أهل البيت^ على النّاس بلاء حَسَن؛ لأنّهم يرشدونهم إلى طريق الهداية والصلاح، وبلاء أهل الكوفة بلاء شرّ سيصيبهم بسبب عدم طاعتهم لأهل البيت^.
ثمّ أشارت إلى موقف أهل الكوفة من الإمام علي بن أبي طالب وأولاده، بتكذيبهم وتكفيرهم واستحلال دمائهم، وقتلهم، ونهب أموالهم، كأنّهم سبايا من التُرك والديلم، وهذا ليس بغريب على أهل الكوفة، فقد قتلوا عليّاً بالأمس القريب، وإنّ سيوفهم تقطر من دماء أهل البيت^، ذلك حقد في القلوب تجاههم.
ثمّ أكّدت على أنّ ما حصل كان في كتاب مبين، فلا يأس على ما فات، ولا فرح بما هو آت، وإنّ الله تعالى لا يُحب المختال ذا العجب بنفسه، ووعدتهم بعذاب الدنيا الإلهي جزاءً على ما اقترفوه، لقتلهم وظلمهم لأهل البيت^،فضلاً عمّا ينتظرهم من عذاب الآخرة الطويل.
وبينت فاطمة‘ أنّ بجدّها الإمام علي بن أبي طالب وبنيه^ اهتدى النّاس إلى الإسلام، وأنّ حسدكم لهم كان لتفضيل الله تعالى لهم عليكم.
وفي ردّها على مَن افتخر بقتل الإمام علي بن أبي طالب×، ساقت مجموعة من الكلمات الواحدة تلوَ الأخرى، مُشَكِّلة صورة واقعية إبداعية، لتسلّط الضوء على ما يجري من أحداث في المجتمع، والتنبّؤ بما سيحدث مستقبلاً، انطلاقاً من قراءة تجارب سابقة، ليكون وسيلة لتغيّر نفوس مَن حولها، الذين يسمعون خطبتها([611])، فذكرت أنّه أنت أيّها المفتخر بقتل علي× مُلِئ فمُك حجراً وتراباً، وعليك السكوت، وإنّك ستقع حتى لو استندت إلى ما يجعلك جالساً لا مطروحاً على الأرض، واستشهدت بآيات من القرآن الكريم لتُؤكِّد تسليم الأمور إلى الله تعالى، والاتّكال عليه، وإنّ كلّ ما يصيبهم فهو بعين الله، وإنّهم في ظلّ العطاء الإلهي والفيض الرباني عليهم دون غيرهم، وإنّ قيمهم التي منها ينطّلقون لا تخرج عن قيم الدين الإسلامي الذي يبشّرون به، فهم راضون بقدر اللهوقضائه.
لقد تمكّنت فاطمة بنت الحسين÷ بهذه الكلمات البليغة أن تأسر قلوب أهل الكوفة وتُحرّك مشاعرهم، وتجعلهم يشعرون بالخيبة والندامة على ما قدّمت أيديهم، فتعالى بكاؤهم وصراخهم للدرجة التي قالوا لها: كفاك يا بنت الطيبين، لقد آذيتينا.
خطبة أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب ^ في أهل الكوفة
أمّ كلثوم هي من زوجة أخرى لعلي بن أبي طالب×، وزوجها ابن عمّها مسلم ابن عقيل، وقد وَلَدت له بنتاً تُدعى حميدة، زوجها ابن عمّها عبد الله بن محمّد بن عقيل([612]).
لقد أدّت أمّ كلثوم الوسطى دور الشراكة مع أختها السيّدة زينب‘ في تحمّل العبء، الذي نهضت به بعد استشهاد الإمام الحسين× وآله وأنصاره، وسبي عياله، ومع حُزنها وأساها فإنّها تميّزت في خطبتها بين حشود أهل الكوفة، التي ألهبت المشاعر آنذاك ، فأومأت إليهم بالسكوت، ثمّ بدأت كلامها من وراء كلّتها، رافعةً صوتها بالبكاء، فقالت: «صه([613])يا أهل الكوفة، تقتلنا رجالكم، وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل الخطاب، يا أهل الكوفة واه لكم، مالكم خذلتم حسينا وقتلتموه، وانتهبتم أمواله وورثتموه، وسبيتم نساءه ونكبتموه، فتبّاً([614])لكم وسحقاً([615])، ويلكم أتدرون أيَّ دواهٍ دهتكم؟([616])، وأيّ وزر على ظهوركم حملتم؟ وأيّ دماء سفكتموها؟ وأيّ كريمة أصبتموها؟ وأيّ صبية سلبتموها؟ وأيّ أموال انتهبتموها؟ قتلتم خير الرجالات بعد النبي، ونزعت الرحمة من قلوبكم ألا إنّ (حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)([617])و(حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)([618])»([619]).
وعند سماع هذه الخطبة «ضجّ النّاس بالبكاء والنواح، ونشرت النساء شعورهن، ودعونَ بالويل والثبور([620])، وبكى الرجال ونتفوا لحاهم، فلم يُرَ باكٍ ولا باكية أكثر من ذلك اليوم»([621]).
لقد كانت خطبة أمّ كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالب× ـ التي جاءت بعد خطبة بنت أخيها فاطمة بنت الحسين× ـ ذات أهمية لا تقلّ عن خُطب مَن سبقها في البلاغة والفصاحة، فإنّها قد بدأت كلامها بزجر النّاس؛ لكي يسكتوا ويسمعوا ما تريد إسماعه لهم بقولها: «صه يا أهل الكوفة»، ثمّ إنّها أبدت استغرابها وتساؤلها من فعل أهل الكوفة، ففي الوقت الذي قتل فيه رجالهم الإمام الحسين× وأهل بيته وأنصاره، تقوم نساؤهم بالبكاء على الإمام الحسين× ومَن قُتِل معه. وقد أوضحت لهم أنّ الذي سيقضي بيننا وبينكم على فعلكم هو الله تعالى يوم القيامة.
وعاودت تساؤلها مع أهل الكوفة عن الأسباب التي دعتهم إلى طاعة ابن زياد وخذلان أخيها الإمام الحسين×، وليس قتله× فحسب، بل وسبي عياله وسلب أمواله. ومع تساؤلها هذا كانت تعلم أنّ أهل الكوفة غير قادرين على الردّ، ولهذا كانت تريد توبيخهم وتقريعهم على فعلتهم الشنيعة التي ارتكبوها، قائلةً لهم: «ويلكم أهل الكوفة قتلتم خير الرجالات بعد الرسول، فسحقاً لكم، وتبّت أيديكم، والنصر سيكون لآل محمد»، وبعد ذلك استشهدت بآية من القرآن الكريم، موضحةً لهم من خلالها أنّ الفوز سيكون للمؤمنين، وهم آل محمد^ ومَن تبعهم، والخسارة للفاسقين، وهم بنو أميّة ومَن تبعهم، ألا إنّ (حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ)([622])، و(حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ)([623])، وهنا تشير إلى الضدّين، فذكر النور يستدعي ذكر الظلام، وذكر الوجود يستدعي ذكر العدم، وهنا جعلت السامع يميّز بين الهزيمة والتضحية، فتضحية أهل البيت^ رغم قتلهم هي النصر، ولبني أميّة الهزيمة رغم قتلهم لأهل البيت^. وهذا فهم جديد نبّهت النّاس عليه، بل هو إشعاع فكريّ، أيقظهم وجعلهم يعرفون ما يهدف إليه أهل البيت^، كما ذكّرتهم بمصيرهم في الدار الآخرة هو العذاب جزاءً لما اقترفوه، ممّا أثّر في نفوس أهل الكوفة، فكان كلامها أشدّ من الصواعق على رؤوسهم، فتركتهم حيارى لا يعرفون مصيرهم. فضجوا بالبكاء والنواح، ونشرت النساء شعورهن، حتى قيل: لم ير باكٍ ولا باكية أكثر من ذلك اليوم.
خطبة الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) × في أهل الكوفة
قبل أن نتحدّث عن خطبة الإمام علي بن الحسين÷ لا بدّ من الإشارة إلى نبذة مختصرة عنه، فهو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم([624])، وأمّه اسمها غزالة([625])، أو شهربانويه([626])، أو شاه زنان بنت كسرى يزدجرد (632ـ652م) آخر ملوك فارس([627])، وقيل: سلامة([628])، وولد في سنة 33هـ/ 653م([629])، وبهذا يكون عمره إبّان معركة الطفّ 27 سنة، بينما أشارت بعض المصادر الأخرى بأنّ عمره كان 23 سنة([630])، وبهذا تكون ولادته في عام 38هـ/ 658م. وزوجته بنت عمّه الحسن السبط فاطمة أمّ عبد الله([631])، وأنجبت له ثلاثة أولاد: الحسين، وعبد الله([632])، ومحمّد الباقر أبو جعفر([633])، وأضيف إليهم الحسن([634])، وأولاده الآخرون من أمّهات ولد شتّى، وهم: عمر، وزيد، وعلي، وخديجة، والحسين الأصغر، وأمّ علي، وأمّ كلثوم، وسليمان لا عقب له، ومليكة، والقاسم، وأمّ الحسن (حسنة)، وأمّ الحسين وفاطمة([635]).
وأشهر أولاد علي السجّاد بعد محمّد الباقر هو زيد، الذي يُعدّ من أفاضل أهل البيت^، وقد قام بثورة ضد الأمويين في الكوفة عام 122هـ/639م، وقتله يوسف بن عمرو الثقفي (120ـ126هـ/737ـ743م) والي الكوفة في عهد هشام ابن عبد الملك (105ـ125هـ/ 723ـ742م)، وصُلِبت جثته على خشبة في محلّة الكناسة([636]). وكان النّاس يأتون إلى هذه الخشبة في الليل ويتعبّدون عندها، وبقي ذلك رسماً عندهم بعد أن أُحرِقت الجثّة ورُفِعت الخشبة، وقيل: إنّ ما من أحد قصد موضع الخشبة لحاجة، ودعا الله تعالى عندها إلّا وقد استُجيب له([637]).
واختلف في السنة التي تُوفّي فيها الإمام علي السجّاد×: فقيل: في محرم سنة 92هـ/710م([638])، أو سنة 94هـ/712م([639])، أو سنة 99هـ/717م، أو سنة 100هـ/718م([640])، ودُفِن في بقيع المدينة المنوّرة، إلى جانب قبر عمّه الإمام الحسن السبط×([641]).
وكان للإمام علي بن الحسين÷ عدد من الكنى، منها: أبو الحسن، وأبو محمّد، وأبو الحسين([642])، ومن ألقابه زين العابدين([643])، والسجّاد، والزكي، والأمين([644])، وذو الثفنات، لُقِّب بذلك؛ لأنّه كان يصلّي كلّ يوم ألف ركعة، فصار في ركبتيه مثل ثفنات البعير([645]).
ووصفه سبط ابن الجوزي بقوله: «كان علي بن الحسين ثقةً مأموناً، كثير الحديث، عالياً رفيعاً، ورعاً عابداً خائفاّ»([646]).
وفي أحد مواسم الحجّ، حجّ هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة الأموية، وأراد أن يلمس الحجر الأسود، فلم يتمكّن من ذلك لازدحام الحجيج، وجاء علي ابن الحسين÷ فوقف النّاس له سماطين([647])، وفتحوا له الطريق بتنحّيهم عن الحجر حتى لمسه، ولم يبق عند الحجر سواه، فأغاظ هذا هشاما وسأل عنه، مَن هذا؟ ولم يجبه أحد، فانبرى الشاعر المشهور الفرزدق([648]) (ت114هـ/732م) قائلاً: أنا أعرفه، وصاح في أبيات من الشعر نذكر بعضها:
|
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجدّه أنبياء الله قد خُتِموا |
وقد أثار الفرزدق بقصيدته هذه غضب هشام بن عبد الملك، فأمر بحبسه في عسفان([649])، وهو موضع بين مكّة والمدينة، فبعث له الإمام علي بن الحسين÷ ألف دينار، وردّها الفرزدق، وبيّن أنّ ما قاله هو لله ورسوله، ولا أجر عليها، فقال الإمام علي× له: «نحن أهل البيت لا يعود إلينا ما خرج منّا»، فقبلها الفرزدق([650]).
وقد سأل رجلٌ الإمامَ عليّاً السجّاد× في يوم ما: كيف أصبحت يا بن رسول الله؟ قال: ويحك أما آن لك أن تعلم كيف أصبحت؟ أصبحنا في قومنا مثل بني إسرائيل في آل فرعون، يُذبِّحون أبناءنا، ويلعنون سيّدنا وشيخنا على المنابر، ويمنعون حقّنا»([651]).
ولا نريد الإطالة في سرد كثير من مناقب الإمام علي بن الحسين÷، لأنه سيخرجنا من موضوعنا.
لا بدّ أن نشير إلى أنّ الإمام علي بن الحسين÷كاد أن يُقتل يوم الطف، وذلك لمّا هجم جيش ابن سعد على المخيّم، وسلب ما سلبوه، انتهوا إلى علي بن الحسين÷ وهو نائم على فراشه؛ لمرضه الشديد، وأرادوا قتله، فدفعهم عنه عمر ابن سعد بقوله: «لا تعرضوا لهؤلاء النسوة، ولا لهذا المريض»([652]).
وفي الكوفة يوم أسره كان له دوره في الخطابة، إذ بدأ خطبته بعد انتهاء عمّاته وأخته من خطبهن، وقد اتّسمت بأنها إغتراف من نهج الآباء والأجداد وامتداد له، كموروث عامّ يتمثّل في القرآن الكريم، والسنّة النبوية الشريفة، وقد أدّت بالنّاس إلى أن يتأثروا تأثّراً كبيراً، وتزداد أحزانهم وتلتهب مشاعرهم، وتتحرّك ضمائرهم مؤنبة إيّاهم على خذلانهم للحسين وأهل بيته.
قال الإمام علي بن الحسين÷: «أيّها النّاس مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني فأنا أعرّفه بنفسي، أنا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنا ابن المذبوح بشطّ الفرات، من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن مَن انتُهِكت حريمه، وسُلِب نعيمه، وانتُهِب ماله، وسُبِي عياله، أنا ابن مَن قُتِل صبراً([653])، وكفى بذلك فخراً. أيّها النّاس ناشدتكم الله، هل تعلمون أنّكم كتبتم إلى أبي، وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة، وقاتلتموه وخذلتموه؟! فتبّاً([654]) لما قدّمتم لأنفسكم، وسوأة لرأيكم، بأيّ عين تنظرون إلى رسول الله’ إذ يقول لكم: قتلتم عترتي، وانتهكتم حرمتي، فلستم من أمّتي؟! فارتفعت أصوات النّاس من كلّ جانب، ويقول بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون.
فقال علي بن الحسين: رحم الله إمرءاً قَبِل نصيحتي، وحفظ وصيّتي في الله، وفي رسوله وأهل بيته، فإنّ لنا في رسول الله أسوةً حسنةً؛ فقالوا جميعاً: نحن كلّنا يا بن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لزمامك([655])، فإنّا حرب لحربك، وسلم لسلمك، لنأخذنَّ يزيدا ونبرأ ممّن ظلمك وظلمنا، فقال علي بن الحسين: هيهات هيهات أيّها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إليّ كما أتيتم إلى أبي من قبل؟ كلا ومسألتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا»([656]).
بدأ الإمام علي بن الحسين÷ مخاطباً حشود أهل الكوفة بتعريف نفسه، وأنّه ابن الذي ذُبح ذبحاً قرب الفرات عطشاناً، لحقد قديم وُرِث من الجاهلية ويوم بدر، وصار جسده هدفاً لتدوس عليه خيل الأعداء. ثمّ عدّد ما تعرّض إليه عياله من السبي، وانتهاك الحرمات، ونهب الأموال، وتفاخر بقتل أبيه صبراً، لأنّه كان صلب الموقف على مبادئه. وإنّكم أهل الكوفة وجّهتم الرسائل للحسين، وطلبتم منه القدوم للكوفة، فكان موقفكم الخداع والخذلان، وكنتم قد اعطيتموه العهد والميثاق والبيعة على التضحية، ثمّ لم تفعلوا ذلك، فهذا سوء الرأي فيكم. وتساءل ماذا تقولون لرسول الله’ وهو يرى ذريته مسبية منتهكة الحرمات؟! وأنّ هذه الأفعال ليست أفعال جماعة مسلمة.
وإزاء هذا التوبيخ والتقريع ضجّ النّاس وارتفعت أصواتهم بالبكاء، وأيقنوا بالهلاك، ثمّ ترحّم على كلّ شخص يأخذ بنصيحته ووصيته، فكان جوابهم: بأنّهم جميعاً عند السمع والطاعة وحفظ قيادته لهم، وأنّهم معه في السلم والحرب، ويتبرّأون من يزيد ومن ظلمه وظلمهم. ولكنّ الإمام علي بن الحسين÷ لم يستجب لذلك؛ لأنّه يخشى منهم الغدر والمكر الذي فعلوه مع أبيه، وإنّ هذا لَمِن شهوات أنفسهم التي لا يمكن تحقّقها.
ممّا يُلاحظ على خطبة الإمام علي بن الحسين÷، وخُطب نساء آل البيت، عمّاته السيّدة زينب وأمّ كلثوم بنات علي بن أبي طالب، وأخته فاطمة بنت الحسين؛ الإشارة إلى حقائق مهمّة، إذ إنّهم ركّزوا على وصف قتل الإمام الحسين× بأنّه ذُبِح ذبحاً، وداست الخيل على صدره، لحقد قديم، وقُتِل وأهل بيته وأنصاره عطاشى بالقرب من نهر الفرات، وبعد ذلك نُهِبت أمواله، وسُبِيت عياله، وانتُهِكت حرمته. ثمّ وجّهوا اللوم إلى أهل الكوفة، لأنهّم يُعدون الجناة الذين ارتكبوا جريمة قتل الإمام الحسين× وآل بيته وأنصاره؛ لأنّهم كاتبوا الإمام الحسين× وأرسلوا إليه الوفود، يلحّون عليه بالقدوم إلى الكوفة، ليكون لهم إماماً في ثورتهم على بني أميّة، وعند تلبية الإمام الحسين× لطلبهم ومجيئه إليهم ظهر منهم الغدر والمكر والخيانة ونقض البيعة، وانقيادهم التامّ لعبيد الله بن زياد الوالي الأموي في الكوفة، وأصبحوا جنوداً وقادة في جيشه الذي قاتل الإمام الحسين× في الطفّ، ولم يُشارك أحد من جند الشام في هذا الجيش، وهكذا صار أهل الكوفة وقود النار التي اقتدح شرارتها جبابرة الظلم والطغيان، يزيد بن معاوية وعبيد الله ابن زياد، وأصبحوا أداة القتل، وبهذا صبّ سبايا أهل البيت^ في خطبهم جلّ غضبهم على أهل الكوفة، وحمّلوهم وزر فاجعة عاشوراء.
ومن هنا تُعدّ خطبة الإمام علي زين العابدين ونساء آل البيت النبوي مصدراً مهمّاً لبيان المجازر التي وقعت يوم عاشوراء، وماحصل للإمام الحسين× وأهل بيته، إذ كانوا شهود عيان لما وقع، فضلاً عمّا تميّز به أهل البيت ـ من رجال ونساء ـ من وعي تامّ وبصيرة للأمور.
سبايا آل البيت^ في قصر الإمارة([657])
بعد أن طِيف بسبايا آل البيت في شوارع الكوفة توجّهوا بهم إلى قصر الإمارة، وهم يخترقون جموع حشود النّاس، الذين كانوا يبكون على ما حلَّ بآل البيت، ثمّ أدخلوا السبايا إلى مجلس ابن زياد، وكانوا في حالة يُرثى لها من العناء والألم، وكانت في طليعتهم السيّدة زينب بنت علي÷، التي تنكّرت وانحازت إلى جانب من المسجد، وحفّت بها بقيّة النساء، ولعلم ابن زياد بمكانة السيّدة زينب‘ في أهل البيت ممّا جعله يبدي شماتته، إذ «قال ابن زياد: مَن الجالسة؟ فلم تكلّمه، وقال الثانية: مَن الجالسة؟ فلم تكلّمه. فقال رجل من أصحابه: هذه زينب بنت علي، فقال ابن زياد: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم([658])، فقالت زينب: «الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمّد، وطهّرنا بكتابه تطهيراً، وإنّما يفتضح الفاسق، ويكذب الفاجر، وهو غيرنا، فقال ابن زياد: كيف رأيتِ صُنع الله بأخيكِ وأهل بيتكِ؟ فقالت زينب: ما رأيت إلّا جميلاً، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم([659])، وسيجمع الله بينك وبينهم يا ابن زياد فتحاجّون وتخاصمون، فانظر لِمَن الفلج([660])يومئذ؟ ثكلتك أمُّك يا ابن مرجانة!»، فغضب ابن زياد من ذلك وكأنّه همَّ بضربها، فقال له عمرو بن حريث المخزومي([661]): أصلح الله الأمير إنّها امرأة، والمرأة لا تُؤاخذ بشيء من منطقها، فقال ابن زياد: لقد أشفى الله نفسي من طاغيتك الحسين والعصاة المردة([662])من أهل بيتك، فرقّت زينب وبكت وقالت: «لقد قتلت كهلي([663])، وقطعت فرعي([664])، وأجتثثت([665])أصلي، فإن كان هذا شفاؤك فقد إشتفيت. فقال ابن زياد: هذه سجّاعة([666])لا جرم([667])، لعمري لقد كان أبوك شاعراً سجّاعاً. فقالت زينب: «يا ابن زياد! وما للمرأة والسجاعة، وإنّ لي عن السجاعة لشغلاً»([668]).
ويذكر الصدوق أنّ ابن زياد قال لأمّ كلثوم: «الحمد لله الذي قتل رجالكم، فكيف ترون ما فعل بكم؟ فقالت يا ابن زياد: لئن قرّت عينك بقتل الحسين فطالما قرّت عين جدّه، وكان يقبله ويلثم شفتيه، ويضعه على عاتقه، يا ابن زياد أعدّ لجدّه جواباً فإنّه خصمك غداً»([669]).
ونعتقد هنا أنّ هذا الحوار جرى بين ابن زياد، والسيّدة زينب‘، وأنّ الصدوق سمّى السيّدة زينب بكنيتها أمّ كلثوم، لأنّه لم يرد في المصادر التي بين أيدينا حوار قد جرى بين ابن زياد وأمّ كلثوم بنت علي÷.
والتفت ابن زياد إلى علي بن الحسين÷ «فقال له: مَن أنت؟ قال: أنا علي بن الحسين، قال ابن زياد: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ فسكت عنه علي بن الحسين÷. قال ابن زياد: ما لك لا تتكلّم؟ قال علي بن الحسين÷: ذاك أخي يُقال له علي قد قتله النّاس، وأنّ له منكم مطلباً يوم القيامة، فقال ابن زياد: بل الله قتله، فقال علي: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)([670])، وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا)([671])، فقال ابن زياد: ألك جرأة على جوابي؟ إذهبوا به فاضربوا عنقه، فسمعت به عمّته زينب، فقالت يا ابن زياد إنّك لم تُبقِ منّا أحداً، فإن كنت عزمت على قتله فاقتلني معه، فقال علي لعمّته: أسكتي حتى أكلّمه؟ ثمّ أقبل على ابن زياد، فقال له: أبالقتل تهددني؟ أما علمت أنّ القتل لنا عادة، وكرامتنا الشهادة! فقال ابن زياد: دعوه ينطلق مع نسائه، ثمّ قال: أخرجوهم عنّي»([672])، فأخرجوا آل البيت^ إلى دار قرب دار الإمارة، وأمر ابن زياد بعد ذلك بحبس سبايا آل البيت في دار إلى جوار دار الإمارة.
وأشار حاجب عبيد الله بن زياد إلى وصف حال السبايا، وحملهم إلى السجن بعد انتهاء ابن زياد من مقابلتهم، بقوله: «ثمّ أمر بعلي بن الحسين، فغلّ وحمل مع النسوة السبايا إلى السجن، وكنت معهم، فما مررنا بزقاق إلّا وجدناه مملوءاً رجالاً ونساءً يضربون وجوههم ويبكون»([673]).
وبهذا فقد تمّ إيداع السبايا السجن، سواء أكان داخل قصر الإمارة أم في مكان آخر، ولكنّه لا يبعد عن دار الإمارة إلّا قليلاً.
لقد أكّد بعض المؤرِّخين حبس آل البيت بروايات مختلفة، منها: ما رواه البلاذري: إنّ أفضل ما فعله ابن زياد هو أمره بمنزل للسبايا في مكان منعزل، وأجرى لهم رزقاً وكسوة ونفقة([674]). وروى ابن الأثير بأنّ سبايا آل الحسين^ لمّا وصلوا إلى الكوفة حبسهم ابن زياد، وأرسل إلى يزيد بالخبر([675]). وروى ابن طاووس بأنّ ابن زياد أمر بعلي بن الحسين÷ وأهله بأن يحملوا إلى دار جنب المسجد الأعظم([676]).
ويُذكر أنّه عند دخول النسوة على ابن زياد ورأس الإمام الحسين× أمامه في طشت، لم تتمالك الرباب زوجة الإمام الحسين× نفسها، فوقعت عليه تُقَبّله، وقالت:
|
إنّ الذي كان نوراً يُستضاء به والله لا أبتغي صهراً بصهركم حتى أُغيّب بين الماء والطينِ([677]). |
وأشار سبط بن الجوزي إلى أنّ الرباب أخذت رأس الإمام الحسين× ووضعته في حجرها وقبلته، وقالت:
|
واحسيناً فلا نسيت حسيناً |
يُلاحظ ممّا تقدّم أنّ ابن زياد كان هدفه من إدخال سبايا أهل البيت^ إلى قصره، الظهور أمام أركان سلطته وجمهوره بهيئة المنتصر صاحب الزهو، على ما حقّقه من انتصارات مزعومة من قتله وسبيه لأهل البيت^، ولكنّه لم يحسب حسابه جيداً؛ إذ اصطدم ـ من خلال حواره مع السبايا ـ بشخصيّتينِ قويّتينِ متسلحتينِ بالإيمان، هزّتا ولطمتا وجهه، ولقّمتا فاه بحجر عدّة مرات، وهما الإمام علي بن الحسين÷ وعمّته السيّدة زينب بنت علي÷، اللذانِ أسقطا كلّ ادعاءاته، وأثارا عليه جلساءه، فصار يرعد ويعربد.
لقد ظهر ابن زياد في حواره كاشفاً عن حقده وعدائه ـ ومن ورائه أسياده بنو أميّة ـ لأهل البيت^، شامتاً متشفّياً بهم، ومتعدّياً بحمده لله تعالى على قتلهم وسبي عيالهم، زاعماً بأنّ قتلهم ـ أي أهل البيت^ ـ فضح إدعاءاتهم الكاذبة، ولكن أيّ فضيحة يقصد بها ابن زياد ؟ وهل يفتضح الذين طهّرهم الله من الرجس تطهيرا؟ وأيّ كذب يدعيه لأهل البيت^؟ إنّ ابن زياد يعدّ تبليغهم للرسالة كذباً، وبهذا فإنّه قد كفر بما أنزله الله تعالى على نبيه، فهل المطالبة بالعدالة والوقوف ضد الظلم والطغيان وأصحابهما كذب، أو من مبادئ الإسلام؟ وما هذه المفاسد التي يجب الوقوف بوجهها إلّا من عمل بني أميّة.
وقد كان ابن زياد في حواره جبّاراً، لا يقبل أيّ ردّ يغيظه من السيّدة زينب× أومن ابن أخيها الإمام علي السجاد×، بل يريد إجابة ترضي غروره.
وكانت السيّدة زينب‘ تتسامى وتترفّع على ابن زياد، ولا تدخل معه في حديث، إلّا أنّ الموقف كان يتطلّب منها ويجبرها على ممارسة الدور الرسالي للدفاع عن ثورة أخيها الإمام الحسين×، وللتأكيد على موقع أهل البيت^ في الأمّة الإسلامية، ولذلك كانت إجابتها على أسئلة ابن زياد متّسمة بالجرأة والشجاعة، ولم تبالِ بجبروته، بل بدّدت هالة سلطته، وتحدّته وجهاً لوجه أمام أعوانه وجمهوره، معلنةً بأنّها لا يساورها أيّ شعور بالهزيمة، وما حدث لأسرتها شيء جميل، بمنطق الرسالة التي يؤمنون بها، ويحملون لواءها، ويبلّغونها العالم، وهي ترى أنّ ما حدث لا يعدو إلّا أن يكون استجابة لأمر الله تعالى، وهم راضون بقضائه والاطمئنان بقدره، بل هم في أقصى غاية الرضا والشكر لله تعالى، الذي فرض الجهاد ضد الظلم والطغيان وأصحابه، وأنّ المعركة قد بدأت ولم تنتهِ، ونهايتها الحاسمة يوم القيامة، وأنّ قاتِل الإمام الحسين× سيكون خصمه الله تعالى ورسوله’، وهناك يكون النصر الحقيقي لأهل البيت^ أصحاب المبادئ الإنسانية السامية.
لقد كانت السيّدة زينب‘ جريئة في ردّها على ابن زياد، ودعت عليه بفقد أمّه له، ممّا جعله يشتاط غضبا، وأخذ يكيل إلى السيّدة زينب‘عبارات جارحة، متشفّياً شامتاً، وهي امرأة عزلاء، فأثار شجونها وأشعل الحزن في داخلها، ومع أنّ إجابتها كانت بلوعة وأسى، إلّا أنّها أشارت إلى جريمته بقتل أهلها في الطفّ، ولم يتمكّن من الردّ عليها، بل هرب بتوصيفه إيّاها بأنّها سجّاعة، وأنّ أباها كان شاعراً وسجّاعاً، فأجابته أين هي من السجع الآن؟! وفي أيّ شغل حتى تتفرّغ لذلك ولغيره؟! وهكذا أثارت مشاعر النّاس، ومن بينهم أقرب المقرّبين من ابن زياد، والذين كانوا يخفّفون من غضبه عندما يأتي الردّ على غير ما يريد.
لم يكن الإمام علي بن الحسين السجّاد÷، ومع ما يعانيه من مرض، أقلّ شأناً من عمّته السيّدة زينب‘، في صلابته وشجاعته التي ورثها من آبائه وأجداده، فمع علمه من أنّ ابن زياد سيأمر بقتله عند أول محاججة بينهما، إلّا أنّ ردوده على ابن زياد كانت قوية، ولم يتردّد في وصف قتلى الطفّ بأنّهم قُتِلوا على أيدي النّاس، وهذا بالطبع لم يرضِ ابن زياد، بل يُغضبه، وقد همّ بقتل الإمام×، إلّا أنّ تعلّق عمّته السيّدة زينب‘ به حال دون ذلك، ومع ذلك فقد ردّ على ابن زياد بعدم خشيته من الموت، لأنّه صار عادةً لأهل بيته، وفيها جائزة كبرى لهم، وهي الشهادة، وأنّ منزلتها الجنّة.
وهنا تكرّرت مواقف الفداء والتضحية التي أبدتها السيّدة زينب‘ في تقديم نفسها لحماية ابن أخيها عندما أراد ابن زياد قتله، فكانت قد منعت الشمر من فعل ذلك في معركة الطفّ.
وهكذا كانت ردود الإمام علي بن الحسين÷ وعمّته السيّدة زينب‘ على ابن زياد، فقد أدّت إلى خيبته وفضحه أمام النّاس في مجلسه، وبهذا أفَشَل الإعلام الزينبي مخُططات سلطة بني أميّة في تعبئة الجماهير ضد ثورة الإمام الحسين×، بل جاءت النتائج عكسية، فقد أجّجت روح الثورة في الأوساط الكوفية ضدّ بني أميّة، وتعاطفت جموع النّاس مع أهل البيت^، وقد شعروا بالندم والخذلان، وطلبوا التوبة في قعودهم عن نصرة الإمام الحسين×، وأدّى إلى تصحيح الانحرافات الفكرية، إذ أحدثت انقلابات ذهنية، فتحوّل الفرد الكوفي من متفرّج إلى باكٍ متحيّر.
وهذا أفرز فيما بعد حركة التوابين([679])، وحركة المختار بن أبي عبيد الثقفي([680]) من رحم المجتمع الكوفي، ومع كلّ ما فعله ابن زياد ـ آنف الذكر ـ أمر بإيداع سبايا أهل البيت^ في السجن!
رواية اختطاف الإمام علي بن الحسين ÷
ذكر بعض المؤرِّخين رواية تُشير إلى تعرّض الإمام علي بن الحسين÷ إلى الاختطاف والتغيّب عن موكب السبايا، وأول مَن نقل هذه الرواية هو ابن سعد (ت230هـ/844م)، حيث نقل قول الإمام علي بن الحسين÷ حيث قال: «غيّبني رجل منهم، وأكرم نزلي واحتضنني، وجعل يبكي كلّما خرج ودخل، حتى كنت أقول: إن يكن عند أحد من النّاس خير ووفاء فعند هذا، إلى أن نادى منادي ابن زياد: ألا مَن وجد علي بن حسين فليأتِ به، فقد جعلنا فيه ثلاثمائة درهم، قال: فدخل والله عليَّ وهو يبكي، وجعل يربط يدي إلى عنقي؟ وهو يقول أخاف منهم؟ وأخرجني والله إليهم مربوطاً، حتى دفعني إليهم، وأخذ ثلاثمائة درهم، وأنا أنظر إليها، فأُخِذتُ، فأدخلت على ابن زياد، فقال: ما اسمك؟ قلتُ: علي بن الحسين، قال: أو لم يقتل الله علياً ؟ قلت: كان لي أخ يُقال له علياً أكبر مني قتله النّاس، قال: بل الله قتله، قلت: الله يتوفّى الأنفس حين موتها، فأمر بقتله، فصاحت زينب بابن زياد: حسبك من دمائنا، أسألك بالله إن قتلته إلّا قتلتني معه، فتركه»([681]). ويتابع ابن سعد في ذكره هذه الرواية كلّ من: ابن عساكر (ت571هـ/1175م)([682])، وابن الجوزي (ت597هـ/ 1200م)([683]) وسبط ابن الجوزي (ت654هـ/1256م)([684]).
يبدو أنّ هذه الرواية فيها كثير من الإرباك؛ لأنّها رواية مرسلة عند ابن سعد، هذا أولاً، وثانيا أنّ الذين ذكروها من بعده ربّما نقلوها منه، ثمّ من غير الممكن أن يتعرّض الإمام علي بن الحسين÷ إلى الاختطاف والتغيّب، ولو لعدّة ساعات، إذا أخذنا بنظر الاعتبار الخطّة التي رُسِمت للاحتفال بدخول السبايا إلى الكوفة، بما فيها من استعدادات أمنية قويّة، فرضها ابن زياد خشيةً من ردود الأفعال. وكما يُفهم من سياق الرواية أنّ الخطف قد أخذ وقتاً قصيراً، نهاراً أو أكثر، بينما مَن يتتبّع دخول موكب السبايا، والذي دخل الكوفة صباحاً، وداروا به في شوارع المدينة، وتخلّله الوقوف عند خُطب بنات الإمام علي وأولاد الحسين^، بمَن فيهم الإمام علي نفسه، إلى وقت الظهيرة، ثمّ أدخلوه على ابن زياد، وجرى ما جرى من حديث بينه وبين السبايا مطوّلاً استمر إلى العصر، ثمّ أمر بإخراجهم عنه وإيداعهم السجن، وهذا أيضاً يكون تحت حراسة مشدّدة.
أمّا إذا سلّمنا أنّ الذي قام بالخطف هو من أزلام ابن زياد ـ كما زعمت الرواية ـ فلا بدّ من القول أين هذا الرجل من عيون السلطة؟! ألا يوجد مَن يُخبر عنه ويأخذ المكافأة له؟! ثمّ كيف يُكافأ مَن خطفه على فعلته؟! لماذا لم يتعرّض إلى المساءلة والمحاسبة؟! ثمّ إنّ الإمام علي بن الحسين÷ هو الوحيد الذي بقي من الرجال، ولم يغب عن نظر النساء الهاشميّات في أثناء السير في الكوفة أو خارجها طرفة عين، ولا سيما عمّته السيّدة زينب‘، التي كان جلّ عملها هو المحافظة عليه ولو كلّفها ذلك حياتها، فكيف تسكت السيّدة زينب‘ وأخواتها عن ذلك؟! فلا بدّ أن يكون لهنَّ موقف في الكشف عنه عند خطفه.
ويظهر من الرواية أنّ دخول الإمام علي بن الحسين÷ على ابن زياد لم يكن مع دخول السبايا، بل دخل وحده بعد أن وجدوه عند أحد أزلام النظام، ولكن الثابت أنّ دخول السبايا كان دخولاً واحداً، وهذا ما يضعف تلك الرواية. كما يُمكن القول ـ احتمالاً ـ أنّ الرجل ـ وهو من أزلام السلطة ـ قد أدرك قلبه العطف والرحمة، فأنزل الإمام من الجمل إلى الأرض، وفكّ عنه القيود ليستريح بعض الوقت، وما أن نُودِي عليه حتى سلّمه إلى الحرس، وأخذ مالاً مقابل ذلك.
مجلس ابن زياد العام وأصداء المعارضة
لقد عقد عبيد الله بن زياد مجلساً عامّاً في المسجد الأعظم، وضمّ إليه كبار قيادات جيشه، وعدداً من صحابة النبي’ وزعماء القبائل العربية، وكذلك عدداً من وجهاء الكوفة. وكان يهدف من وراء عقد مجلسه هذا إعلان انتصاراته التي حقّقها بقتله الإمام الحسين بن علي÷، وأعطى إذنا للناس عامّة بالحضور، وأمر بإحضار رأس الإمام الحسين× فوُضِع بين يديه في طشت، ونظر إلى الرأس مبتسماً، وضرب ثنايا الإمام بقضيب في يده، وقال: «إنّ في حسنه شيئاً؛ فأجابه الصحابي أنس بن مالك ـ خادم النبي’ الذي كان حاضراً في المجلس ـ بقوله: كان أشبههم برسول الله، وكان الرأس مخضباً بالوسمة»([685]).
وفي رواية أخرى قال ابن زياد: «إنّه، أي الإمام الحسين، كان لَحَسَن الثغر»، وقال أنس في نفسه: «لأسوءنّك، لقد رأيتُ رسول الله يُقبّل موضع قضيبك من فيه»([686]). ويذكر ابن حبان أنّ ابن زياد قال: «ما رأيتُ مثل هذا حسناً»([687]). وقيل: إنّ ابن زياد كان يضع قضيبه في أنف الإمام الحسين، فاعترض عليه أنس قائلاً: «إنّي رأيتُ رسولَ الله يلثم حيث يقع قضيبك»([688]).
وقد وصف أنسُ بن مالك حالَ أهل الكوفة ومشاعرهم يوم أوتي برأس الإمام الحسين× فقال: «لم ترَ عين عبرى مثل يوم أوتي برأس الحسين بن علي في طشت، ووُضِع بين يدي عبيد الله ابن زياد لعنهما الله، وجعل يسمه بقضيبه، ويقول: إنّه كان لصبيح، إنّه كان جميلاً»([689]).
واعترض صحابي آخر كان من بين الحاضرين في المجلس، وهو زيد بن أرقم([690])، على فعل ابن زياد برأس الإمام الحسين×، فقال له: «إرفع قضيبك عن هاتينِ الشفتينِ، فوالله الذي لا اله إلّا هو، لقد رأيتُ شفتي رسول الله عليهما ما لا أحصيه»، ثمّ انتحب باكياً. وأضاف ابن أرقم قائلاً لابن زياد: «يا ابن زياد لأحدّثك حديثاً أغلظ من هذا، رأيتُ رسول الله أقعد حسناً على فخذه اليمنى، وحسيناً على فخذه اليسرى، ثمّ وضع يده على يافوخيهما، ثمّ قال: اللهمّ إنّي أستودعك إيّاهما وصالح المؤمنين. فكيف كانت وديعة رسول الله عندك يا ابن زياد؟!»([691])، فالتفت ابن زياد إلى الشيخ ابن أرقم، وطرده من المجلس قائلاً: «أبكى الله عينيك، أتبكي لفتح الله؟! لولا أنّك شيخ قد خرفتَ وذهب عقلك لضربتُ عنقك»، فنهض زيد وذهب إلى منزله([692])، وقيل: إنه عند خروجه كان يقول: «ملك عبد عبداً، فأتّخذه تلداً، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة، وأمّرتم ابن مرجانة حتى يقتل خياركم، ويستعبد أشراركم، فرضيتم بالذل، فبعداً لِمَن رَضي»([693]).
وأشار سبط بن الجوزي إلى فعل آخر يدلّ على أفعال ابن زياد المشينة، حيث ذكر أنّه لمّا وُضِع رأسُ الحسين بين يَدَي ابن زياد في طشت، قال له كاهنه: «قُم فضع قدمك على فَم عدوك»، فقام ابن زياد ووضع قدمه على فَم الحسين، ثمّ قال لزيد بن أرقم: «كيف ترى؟ »، فردّ عليه ابن أرقم قائلاً: «والله لقد رأيتُ رسول الله واضعاً فاهُ حيث وضعت قدمك»([694]).
ثمّ صعد ابن زياد المنبر وخطب في المجلس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال في بعض كلامه: «الحمد لله الذي أظهر الحقّ وأهله، ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزبه، وقتل الكذّاب بن الكذّاب، الحسين بن علي وشيعته»([695])، وما زاد على كلامه هذا حتى نهض إليه عبد الله بن عفيف الأزدي، قائلاً له: «يا ابن مرجانة! صه، فضّ الله فاك، ولعن جدّك وأباك، وعذّبك وأخزاك، وجعل النار مثواك، ما كفاك قتل الحسين عن سبّهم على المنابر؟ ولقد سمعت رسول الله يقول: مَن سبّ علياً فقد سبّني، ومَن سبّني سبّ الله، ومَن سبّ الله كبّه الله على منخريه في النار. الكذّاب ابن الكذّاب أنت وأبوك، ومَن استعملك وأبوه، يا عدوّ الله، أتقتلون أبناء النبيّين، وتتكلّمون بهذا الكلام على منابر المؤمنين؟»([696])، فغضب ابن زياد ثمّ قال: «مَن المتكلّم؟ فأجابه ابن عفيف: أنا المتكلّم يا عدوّ الله! أتقتل الذرية الطاهرة التي قد أذهب الله عنها الرجس في كتابه، وتزعم أنّك على دين الإسلام؟! واه! اين أولاد المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك، اللعين ابن اللعين على لسان محمّد نبي ربّ العالمين»([697])، فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه، وأمر بالقبض عليه، وكان عبد الرحمن بن مخنف الأزدي([698]) جالساً فقال: «ويح غيرك أهلكت نفسك، وأهلكت قومك»([699])، وبادر إليه الجلاوزة من كلّ ناحية فأمسكوا به، فصاح ابن عفيف بشعار الأزد يا مبرور، وحاضر الأزد يومئذ سبعمائة مقاتل، فقام بنو عمّه وخلّصوه من أيديهم،ومن ثمّ أخرجوه من باب المسجد، وذهبوا به إلى منزله([700])، وعند ذلك نزل ابن زياد من المنبر، وانتقل إلى قصر الإمارة، ودخل عليه أشراف النّاس، وعاتبهم على فعل الأزد، وبدورهم تبرأوا من هذا الفعل، ثمّ أرسل ابن زياد إلى عبد الرحمن بن مخنف الأزدي، وسجنه بصحبة جماعة من الأزد كرهائن إلى أن يسلّموا عبد الله بن عفيف له([701]).
لقد اتّخذ ابن زياد إجراءات عدّة إزاء هذه التطوّرات المعارضة لسياسته، فقد استدعى بعض أمراء جيشه، أمثال عمرو بن الحجاج الزبيدي([702])، ومحمّد بن الأشعث، وشبث بن ربعي([703])، وجماعة أخرى من أصحابه، وأمرهم بالذهاب إلى ابن عفيف الأزدي، وأن يأتوا به إليه([704]).
إجتمعت الأزد ومعهم قبائل اليمن؛ ليمنعوا عن صاحبهم عبد الله بن عفيف، بعد وصول أخبار إجراءات ابن زياد، الذي بدوره حال علمه باجتماع القبائل اليمانية جمع قبائل مضر، وضمّهم إلى محمّد بن الأشعث، وأمره بقتال الأزد ومَن معهم، وبهذا نشبت حرب قبلية في أحياء الأزد، اقتتلوا فيها قتالاً شديداً، راح فيها عدد من القتلى، ولم يرض ابن زياد على أمراء جيشه، فأنّبهم على تأخّرهم في حسم المعركة، وقد طلب منه شبث بن ربعي عدم التعجيل لأنّهم يُقاتلون أُسود الآجام. واقتحم أصحاب ابن زياد دار ابن عفيف ودخلوها بعد أن كسروا بابها، ولم يكن مع ابن عفيف في الدار إلّا ابنته، والتي بدورها نبّهت أباها بدخول العدو عليه، ولم تكن مقاومة ابن عفيف لعدوّه مجدية؛ لكونه وحيداً ورجلاً مكفوفاً، وكان يدافع عن نفسه ويقول:
|
انا ابن ذي الفضل عفيف الطاهر |
وذُكر أنّه تمكّن من قتل خمسين رجلاً وهو يصلي على النبي وآله، ويرتجز ويقول:
|
والله لو يكشف لي عن بصـري ضاق عليهم موردي ومصدري([707]) |
وكانت ابنته تتمنّى لو أنّها كانت رجلاً لتقاتل مع أبيها هؤلاء الفجرة قاتلي العترة البررة، وقد اعصوصبوا عليه من كلّ ناحية، وتمكّنوا من مسكه وأخذه إلى ابن زياد، وحينها قال جندب بن عبد الله الأزدي([708]): «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أخذوا والله عبد الله بن عفيف، فأقبح والله العيش من بعدك»([709]). ولكن هذا ظلّ قولاً لا عملاً، فلم يقم الأزد حينها بشيء يُذكر لنصرة ابن عفيف.
أُدخِل عبد الله بن عفيف على ابن زياد، فلمّا رآه ابن زياد قال: «الحمد لله الذي أخزاك، وسأله ابن عفيف: يا عدوّ الله بماذا أخزاني؟ والله لو فرّج الله عن بصري لضاق عليك موردي ومصدري»([710])، وقال له ابن زياد أيضاً: «الحمد لله الذي أعمى عينيك، فقال له ابن عفيف: الحمد لله الذي أعمى قلبك، فقال ابن زياد: يا عدوّ نفسه! ماذا تقول في عثمان بن عفان؟ فقال ابن عفيف: يا ابن عبد بني علاج! ويا ابن مرجانة وسمية! وما أنت وعثمان بن عفان؟ أساء أم أحسن، وأصلح أم أفسد، الله تبارك وتعالى ولي خلقه، يقضي بين خلقه وعثمان بن عفان بالعدل والحقّ، ولكن سلني عن أبيك، وعن يزيد وأبيه! فقال ابن زياد: والله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت، فقال ابن عفيف: الحمد لله ربّ العالمين! أما أنّي قد كنت أسال ربي أن يرزقني الشهادة، والآن فالحمد لله الذي رزقنيها بعد الإياس منها، وعرّفني الإجابة منه لي في قديم دعائي»([711]). وبعد أن فرغ ابن عفيف من انشاد شعره، أمر ابن زياد بضرب عنقه، وصُلِب في السبخة([712]).
وانتهت حياة هذا الرجل الكبير بمبادئه، فهو الذي وهب حياته لله تعالى، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وقال كلمة حقّ عند سلطان جائر في أحلك الظروف وأقساها، وقاوم المنكر وناهض الجور، وهو لم يكن مهيّئاً لذلك جسديّاً.
ثمّ استدعى ابن زياد جندب بن عبد الله الأزدي وقال له: «يا عدوّ الله، ألستَ صاحب علي ابن أبي طالب يوم صفّين، قال: نعم، ولا زلت له وليّاً، ولكم عدوّاً، لا أبرأ من ذلك إليه، ولا أعتذر في ذلك وأتنصّل منه بين يديك، فقال ابن زياد: أما أنّي سأتقرّب إلى الله بدمك، قال جندب: والله لا يقرّبك دمي إلى الله، ولكنّه يباعدك منه، وبعد فإنّي لم يبق من عمري إلّا أقله، وما أكره أن يكرمني الله بهواني، قال ابن زياد: أخرجوه عني، إنه شيخ قد خرّف وذهب عقله»([713]).
إنّ إخلاء سبيل جندب بن عبد الله الأزدي دون أن يقتله ابن زياد لم يكن لأنه شيخ كبير وقد خرف كما يزعم ابن زياد، وقد ملأ قلبه غلاًّ وحقداً عليه، بل لأنّ قتله بعد قتل ابن عفيف سيؤدي إلى تأجيج وتحريض قبيلة الأزد على سلطته في الكوفة، والأزد من القبائل التي لها وزنها المهم في كلّ أمر.
وبهذا سلك ابن زياد طريق الموازنة في تهدئة القبائل الكبيرة، وكسب مودّتها وعدم إثارتها، فعفوه عن جندب ابن عبد الله محاولة لتهدئة ثائرة الأزد بعد تفاقم الوضع، وتأزّم العلاقة معهم، نتيجة وقائع انتفاضة ابن عفيف وقتله. كما أنّ ابن زياد قد عفى عن أشخاص آخرين من الأزد، أمثال سفيان بن يزيد([714])، الذي خرج مع أفراد قبيلته لتخليص عمّه من أسر جند ابن زياد له، وكذلك أطلق سراح عبد الرحمن بن مخنف الأزدي من السجن، وعفا عن إخوته وبني عمّه الذين شاركوا في انتفاضة الأزد([715]).
وهكذا قبلت رؤوس الأزد ـ وهم أُسود الآجام ـ أن تُوادع ابن زياد موادعة ذليلة، فلم يسجّل لأحد من أشراف الأزد أنّه آثر التأسّي بابن عفيف الأزدي، ذي القلب المؤمن الكبير والنفس العزيزة الأبية، الذي انتفض بوجه الطاغية ابن زياد، صارخاً بكلمة الحقّ، ولجرأة صاحبها صعق ابن زياد بها، فنزل عن المنبر مخذولاً مدحوراً، ودخل قصره حائراً في ما يمكن أن يواجه به هذا الثائر الفرد، الذي كان أُمّةً في انتفاضته.
وكان في مجلس ابن زياد، قيس بن عباد([716])، فسأله ابن زياد أنّه ماذا يقول فيه وفي حسين؟ قال: يأتي يوم القيامة جدّه وأبوه وأمّه فيشفعون فيه، ويأتي جدّك وأبوك وأمّك فيشفعون فيك، فلم يقبل ابن زياد بهذا الجواب، فغضب وطرده من المجلس([717]). وهذا يدل على أنّ ابن زياد يعرف تمام المعرفة الفرق بينه وبين الإمام الحسين×، وأنّ فعله في قتله للحسين وأهل بيته وأنصاره هو من الخطأ الذي يُحاسب عليه الحساب الشديد يوم القيامة.
واجه ابن زياد رفضاً داخلياً في أوساط أسرته لقتله الإمام الحسين× وأهل بيته، فقد سخطت عليه أمّه مرجانة، وأنّبته بقولها: «يا خبيث قتلت ابن رسول الله، والله لا ترى الجنّة»([718]).
وكما رفض عثمان بن زياد ـ وهو أخو عبيد الله ـ ما فعله أخوه بقتله الإمام الحسين×، وعنّفه بقوله: «صدق والله، لوددت أنّه ليس من بني زياد رجل إلّا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة، وأنّ حسيناً لم يقتل»([719])، ومعناه أنّ عثمان يُفضّل أن تُوضع في أنوف رجال بني زياد ما يُوضع في أنوف النساء من الخزامة التي تتحلّى وتتزيّن بها المرأة، هذا الأمر خير من أن يعملوا ما ينقص من قدرهم كرجال إلى يوم القيامة، ويقتلوا الإمام الحسين×.
وقد أُقِيم في الدار التي أودع فيها سبايا أهل البيت^ ـ وهي مجاورة لقصر الإمارة، وعلى مسمع من آذان ابن زياد ـ مأتمٌ في تلك الليلة إلى الصباح، وقد جاءت نساء أهل الكوفة لمواساة عائلة الإمام الحسين×، ولكن السيّدة زينب‘ لم تسمح للجميع بالدخول عليهنّ، وخاصّةً العربيات، وسمحت فقط لمَن كانت أمّ ولد أو مملوكة؛ لأنهنّ تعرضنَ للسبي مثل نساء أهل البيت^([720]). وهذا شكل من أشكال الرفض، عبّرنَ عنه نساء الكوفة لما فعلته سلطة بني أميّة في الكوفة.
معارضة المختار الثقفي لقتل الإمام الحسين×
في الجمعة التي تلت قتل عبد الله بن عفيف الأزدي، صعد ابن زياد المنبر في مسجد الكوفة الأعظم وبيده قضيب، ولا زال يردّد على أذهان النّاس انتصاراته المزعومة، وفي آخر خطبته التي خطب فيها النّاس في ذلك اليوم قال: «الحمد لله الذي أعزّ يزيد وجيشه بالعزّ والنصر، وأذلّ الحسين وجيشه بالقتل»([721])، فقام إليه المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان جالساً يسمع الخطبة، وهو يُعدّ من أشراف أهل الكوفة دون أن يتركه يكمل، وقال له: «كذبت يا عدوّ الله وعدوّ رسوله، بل الحمد لله الذي أعزّ الحسين وجيشه بالجنّة والمغفرة، وأذلّ يزيد وجيشه بالنّار والخزي»([722]).
ويبدو أنّ ابن زياد لم يكن يعرف المختار من قبل، فعرّفه أهل الكوفة بحسبه ونسبه، وأنّ ختنه عمر بن سعد، وختنه الآخر عبد الله بن عمر بن الخطاب، فأوجس ابن زياد في نفسه خيفة من أن يتّخذ قراراً ما، ومع ذلك ضربه بسوط وذهبت عينه([723])، وحبسه ولم يتجرّأ على قتله.
وكتب المختار إلى عبد الله بن عمركتابا وضّح فيه القصّة، ممّا جعل الأخير يكتب غاضباً إلى يزيد بن معاوية جاء فيه: « أمّا بعد، أفما رضيت بأن قتلت أهل نبيّك حتى ولّيتَ على المسلمين مَن يَسبّ أهل بيت نبيّنا، ويقع فيهم على المنبر! عبر عليه ابن عفيف فقتله، ثمّ عبر عليه المختار فشجّه وقيّده وحبسه، فإذا أنت قرأت كتابي هذا فاكتب إلى ابن زياد لإطلاق المختار، وإلا فوالله لأرمينَّ عبيد الله وجيشه بجيشٍ لا طاقة له به، والسلام»([724]). وقد غضب يزيد من أفعال ابن زياد هذه، ولم يرض عليه، بعد أن عرفها عند قراءته كتاب ابن عمر، فكتب إلى ابن زياد مؤنّباً: «أمّا بعد: فقد ولّيتك العراق، ولم أولّكَ على أن تسبّ آل النبي على المنابر، وتقع فيهم، فإذا أتاك كتابي فأطلق المختار من حبسك مكرّماً، وإيّاك أن تعود إلى ما فعلت، وإلّا فو الذي نفسي بيده بعثت إليك مَن أخذ منك الذي فيه عينك»([725])، وعند وصول الكتاب أمر ابن زياد بإخراج المختار من حبسه، ودعا شيوخ أهل الكوفة وسلّمه إليّهم سالماً، وبعدها خرج المختار من الكوفة نحو الحجاز([726]).
يُلاحظ على هذه الرواية نوع من المبالغة، فكيف يمكن لعبد الله بن عمر أن يُخاطب يزيد بن معاوية بهذه اللهجة التي فيها تهديد ووعيد، كما أنّ يزيد لا يُمكن أن يغضب على عبيد الله بن زياد وهو المنفّذ لأوامره، ولاسيما فيما يتعلّق بسياسة السبّ التي اتُبِعت ضدّ آل البيت، والتي بقيت تُمارس على المنابر حتى رُفِعت من قِبَل عمر بن عبد العزيز([727]).
عندما أُحضِر رأسُ الإمام الحسين× لابن زياد أمر بتقويره حتى يُنصب على الرمح. والتقوير: هو قطع الشيء دائرياً وإفراغ محتواه([728]). وقد تهرّب كثير من الذين كانوا في مجلس ابن زياد من فعل ذلك، إلا حجّاماً من بينهم يُدعى طارق بن المبارك، حيث تصدى لفعل ذلك، وقوّر الرأس الشريف وأفرغه من داخله، ونصبه بباب المسجد الأعظم([729]). وقد رُفِع من رأس الإمام الحسين× لغاديده ـ وهي ما بين الحنك وصفحة العنق من اللحم ـ ونخاعه وما حوله من اللحم. وقد طلب عمرو بن حريث المخزومي من ابن زياد أن يعطيه ما استُخرِج من الرأس، فأُعطِيَ له وجمعه في مطرفة خزّ كان يرتديها، وحمل ذلك إلى داره، وغسله وطيّبه وكفّنه ودفنه في داره، وهي في الكوفة تعرف بدار الخزّ ـ دار عمرو بن حريث المخزومي([730]) ـ وكانت دار الخزّ هذه مشهورة، يذكر الخطيب البغدادي أنّ أبا حنيفة النعمان بن ثابت (ت150هـ/767م) كان يعمل خزّازاً معروفاً بدار عمرو بن حريث المخزومي([731]).
ويبدو أنّ عمرو بن حريث كانت له مواقف طيبة تجاه سبايا أهل البيت^، فضلاً عن فعله آنف الذكر، فإنّه قام بتهدئة ابن زياد عندما همّ بضرب السيّدة زينب‘ في أثناء حواره معها عند دخول السبايا قصر الإمارة([732]).
وإزاء أفعال عبيد الله بن زياد المشينة، التي ليس لها أي صلة بأيّ خلق إنساني، فمرّةً يضرب بقضبيه شَفَتَي الإمام الحسين× مبتسماً متشفيّاً، ومرّةً يضع قدمه على رأس الإمام الحسين× وبأمر من كاهنه، ومرّةً يأمر بتقوير رأس الإمام الحسين×؛ فانّنا نقف أمام مثل هذه الأفعال حيارى، ونتساءل ونحن مشتّتو الأفكار إزاء هذه الأفعال التي يصطدم بها كلّ ذي لبّ: هل أنّ هذه الأفعال تنمّ عن شجاعة رجل مسؤول في الدولة؟! وهل هـو مسلم حقيقي؟! نكتفي بهذا، لأنّنا لم نجد من الكلام ردّاً وافياً على مثل هذه الأفعال!!.
الطواف برأس الإمام الحسين× في شوارع الكوفة
أمر ابن زياد في صباح اليوم الثالث عشر من المحرم أن يُطاف ويُدار برأس الإمام الحسين× في كلّ سكك الكوفة، وخطط قبائلها([733]).
يروي زيد بن أرقم: أنّه كان جالساً في إحدى غرف بيته وشاهد مرور رأس الإمام الحسين× وهو على رمح طويل، ولما حاذاه ـ أي الرأس الشريف ـ سمعه يقرأ: (أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا)([734])، وعندها وقف ابن أرقم ونادى : رأس ابن رسول الله أعجب. ولما انتهوا من التطواف في شوارع المدينة رُدّ الرأس إلى باب القصر([735]).
وقد نطق رأس الإمام الحسين× بحجة في أكثر من موضع، وهذا يكشف عن كرامته وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، وهذا ليس بغريب على رجل مظلوم كلّه قيم ومبادئ، ولا يوجد ابن بنت رسول غيره في مشارق الأرض ومغاربها.
ويذكر سبط بن الجوزي أنّ ابن زياد قد نصب الرؤوس كلّها في الكوفة على الخشب، وهي أول رؤوس نُصِبت في الإسلام بعد رأس مسلم بن عقيل، الذي نُصِب على الخشب في الكوفة أيضاً([736]).
لم يبق سبايا آل البيت^ في الكوفة مدّة طويلة إلّا يومين، كما تشير بعض الروايات([737]) وقد كتب ابن زياد في هذه المدّة القصيرة إلى يزيد بن معاوية، يخبره بانتصاراته وقتله الإمام الحسين بن علي÷ وسبي عياله.
وقد أودع آل البيت السبايا السجن المجاور لقصره، وبينما هم في السجن سقط عليهم حجر مربوط فيه كتاب، يعلمهم بأن البريد([738]) سار إلى يزيد لإخباره بأمركم، وسيصل يوم كذا ويعود يوم كذا، وعند عودة البريد إذا سمعتم بالتكبير فقد جاء الأمر بقتلكم، وإن لم تسمعوا ذلك فأنتم في أمان. وقبل عودة البريد بيومين أو ثلاثة وقع عليهم كتاب آخر بالطريقة نفسها، وفيه بأن يُوصوا ويعهدوا فقد قارب رجوع البريد([739]).
ويبدو على هذه الرواية الإرباك، حيث لم تحدّد مدّة ذهاب البريد([740]) ومدّة عودته أيضا، ولكن يمكن القول إحتمالاً ـ من خلال فهم هذه الرواية ـ أنّ مدّة وصول البريد وعودته كانت يومين أو ثلاثة أيام.
ويذكر ابن سعد أنّ يزيد بن معاوية كتب إلى ابن زياد يأمره بإرسال سبايا آل البيت^، ورأس الإمام الحسين بن علي÷، وبقية رؤوس القتلى إلى دمشق مقرّ الحكم الأموي([741]). وحسب قول سبط بن الجوزي «إنّ ابن زياد حطّ الرؤوس في اليوم الثاني، وجهّزها والسبايا إلى الشام إلى يزيد بن معاوية»([742]).
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ عبيد الله بن زياد كان يعمل ويتصرّف من موقع قادر، وذلك لتمتّعه بصلاحيات واسعة عند توليته الكوفة، وخاصّةً تلك التي من خلالها يقوم بتثبيت دعائم الحكم الأموي، فضلاً عن أنّه يُعدّ مقرباً من عائلة يزيد ابن معاوية، حيث إن معاوية بن أبي سفيان إبّان عهده استلحق زياداً أبا عبيد الله، وجعله أخاً له، ومنذ ذلك الحين أصبح يُسمّى زياد بن أبي سفيان، بعد أن كان زياد مجهول الأب([743]).
وبالتالي فإنّ ابن زياد وإن أخبر يزيد بأحداث الطفّ،إلّا أنّه لا يحتاج أمراً ليقوم بإرسال السبايا ورؤوس القتلى إلى حاضرة حكم بني أميّة، لأنّه كان من المعتاد عند الولاة الأمويين عند قتل أي معارض لحكمهم، غالباً ما يقومون بقطع رأسه، وإرساله إلى مقرّ الحاكم الأموي في دمشق، وهناك شواهد على ذلك سنقوم بذكرها في فصول قادمة([744]).
ثمّ إن ابن زياد ـ فضلاً عمّا ذُكِر ـ لا يرغب ببقاء سبايا آل البيت مدّة أطول في الكوفة؛ خشيةً من هياج أهلها، ولاسيما بعد خُطَب السيّدة زينب وأمّ كلثوم بِنتَي أمير المؤمنين، وفاطمة بنت الحسين وأخيها الإمام علي السجاد÷؛ التي ألهبت المشاعر، وغيّرت المواقف في أوساط المجتمع الكوفي، وحتى في الدائرة القريبة من ابن زياد، فكان بعض رجال شرطته أو إدارته ـ وإن لم يكونوا من الموالين لآل البيت ـ يبدون تعاطفاً مع سبايا آل البيت، وبدون علمه أخذوا يخبرونهم بما يجري من أحداث خارج السجن، من توجيه ابن زياد كتاباً إلى يزيد وعودة جوابه.
إنّ الروايات التاريخية لم تُحدِّد بشكل دقيق مدّة بقاء سبايا آل البيت في الكوفة، ولكن يمكن حساب ذلك، إذ وصل سبايا آل البيت مشارف الكوفة ليلة الثاني عشر من المحرم، وفي صباح اليوم الثاني عشر دخلوا الكوفة، وكانت أحداثه متواصلة طوال ذلك اليوم، من استعراضهم في شوارع المدينة التي عجّت بالنّاس المتفرّجين، وخُطب السيّدة زينب وأمّ كلثوم وفاطمة والإمام علي السجاد^ في تلك الحشود، وبعد ذلك إدخالهم على ابن زياد في قصر الإمارة، والحديث المطوّل بينه وبين كلّ من السيّدة زينب‘ والإمام علي السجاد×، ثمّ أمره إيداعهم السجن، وعقد مجلسه العام، وحديثه في هذا المجلس مبيّناً النصر الذي حقّقه كما يزعم، ومعارضته من قبل صحابة النبي’ ومن الموالين لآل البيت ومحبّيهم، وتطوّر تلك المعارضة إلى معركة بين قبيلة الأزد وشرطة ابن زياد، وأخذتْ وقتاً من ليل الثالث عشر، وقد قُتِل فيها عبد الله بن عفيف الأزدي، وفي صبيحة اليوم الثالث عشر من المحرّم أمر ابن زياد بالطواف برأس الإمام الحسين× وبقية رؤوس القتلى في شوارع وسكك الكوفة، وخطط قبائلها، في وسط حشود النّاس الذين كان أكثرهم ناقمين على فعل ابن زياد، ويبدو أنّ هذا الطواف برؤوس القتلى أخذ وقتا حتى قارب وقت الظهيرة، وبعد ذلك أمر ابن زياد بنصب جميع الرؤوس على الخشب أمام مسجد الكوفة الأعظم، وبفعله هذا ازداد هياج النّاس، ولخشيته من تفاقم الأمر من جهة، ووصول كتاب يزيد بن معاوية بتوجيه سبايا آل البيت إلى دمشق من جهة أخرى؛ عجّل ابن زياد في ليل الخامس عشر من المحرّم بتوجيه سبايا آل البيت^إلى الشام. وبهذا كانت مدّة بقاء سبايا آل البيت في الكوفة لا تتجاوز ثلاثة أيّام، من ليلة الثاني عشر إلى ليلة الخامس عشر من المحرّم.
جهّز ابن زياد السبايا من النساء والصبيان ورأس الإمام الحسين× وبقية الرؤوس، وقد غلّ الإمام علي السجّاد× إلى عنقه([745])، لينطلق الجميع إلى بلاد الشام، وأصحبهم بعدد كافٍ من أفراد وقادة جيشه؛ ليكونوا أشدّ حراسة عليهم في الطريق وصولاً إلى دمشق([746]).
وخلاصة ما تقدّم: كان دخول عائلة الإمام الحسين× السبايا إلى الكوفة في صبيحة اليوم الثاني عشر من المحرم. وقد اتّخذ عبيد الله بن زياد عدّة إجراءات خشيةً من ردود أفعال أهل الكوفة، عند رؤيتهم وعلمهم بأنّ السبايا هم آل البيت، عائلة الإمام الحسين^، وليسوا من الخوارج، كما روّج لذلك أمويّو الكوفة. وهذه الإجراءات كلّها إعلان لحالة الطوارئ.
وعندما علم أهل الكوفة ـ الذين قد عرفوا بقدوم السبايا قبل دخولهم المدينة ـ تجمّعوا منذ الصباح الباكر بشكل جماعات، ينتظرون رؤية السبايا، وقد تباينت مواقفهم، فمنهم ذو ميول أموية ويُؤيدون ذلك، وانضمّ إليهم مَن كان جاهلاً بالأحداث، ومنهم مَن كان يعرف ما حدث ولكن ليس بمقدوره فعل شيء.
وقد عُدَّ دخول السبايا للكوفة احتفالا عسكرياً ابتهاجاً بالنصر، وتقوم شرطة ابن زياد بالتجوال بهم مع الرؤوس في شوارع المدينة. والهدف من كلّ ذلك هو زرع الخوف في نفوس كلّ مَن يُريد الثورة ضد الأمويين، وأنّ حالهُ سيكون كحال الإمام الحسين× من القتل وسبي عياله.
ولكن لم تَجرِ أحداث ذلك اليوم كما رُسِم لها، بل كانت خُطَب النساء العلويّات والإمام علي السجاد× ـ أولاد الرسالة المحمديّة ـ بين حشود أهالي الكوفة قد قلبت ظهر المجن على رأس صاحبه، إذ أدّوا بذلك دوراً إعلامياً مهماًّ مع ما فيهم من عظم المصيبة والألم، إذ فقدوا رجالهم وإخوتهم وأبناءهم وأبناء عمومتهم، ونُهِبت أموالهم، وهُتِك حجابهم، وتمّ سبيهم من الطفّ إلى الكوفة. ومع كلّ ما ألمّ بهم تمكّنوا من فضح بني أميّة بتوعيّة النّاس، وتعريفهم بحقائق الأحداث، وأنّهم آل البيت لا خوارج، مع إبراز أهداف الثورة الحسينية. ومن اللواتي قُمنَ بهذا الدور السيّدة زينب‘ وأختها أمّ كلثوم بنتا علي بن أبي طالب×، وبنت أخيهما فاطمة بنت الحسين×، فضلاً عن الإمام علي بن الحسين÷، مع ما يُعانيه من المرض الشديد.
وقد أكّدت جميع الخُطب على توبيخ وتقريع أهل الكوفة على خذلانهم للحسين بعد دعوته، ليكون إماماً لهم في الثورة على الأمويين، وتحميلهم المسؤولية المباشرة عن قتل الإمام الحسين× وأهل بيته وأنصاره؛ لأنّ الجنود والقادة في الجيش الذي قتل الإمام الحسين× وسبى عياله ونهب أمواله كانوا من أهل الكوفة.
وبعد أنِ انتهى طواف السبايا في شوارع المدينة أُدخِلوا محلّ ابن زياد ومجلسه، ودارت في هذا المجلس حوارات بين ابن زياد من جهة، والسيّدة زينب‘ والإمام علي بن الحسين÷ من جهة اخرى، ورغم تشفّيه بهما إلّا أنّهما قد أفشلا ما كان يبغيهِ من لقائه بهما وبسائر السبايا ، وبعد ذلك أمر بإخراجهم من مجلسه وإيداعهم السجن.
وفي مجلسه المنعقد ظهر ابن زياد أمام جلسائه منتشيّاً مبتسماً، يلاعب بقضيب في يده شَفَتَي رأس الإمام الحسين×الذي وُضِع أمامه في طشت، وهذا أثار امتعاض واعتراض بعض الجالسين، كالصحابي زيد بن أرقم الذي طُرد من المجلس بسبب ذلك. وعندما خطب ابن زياد نال من الإمام الحسين×، وبجّل سيّده يزيد بن معاوية، فنهض إليه عبد الله بن عفيف الأزدي، فشتمه وشتم سيّده، وطالب أبناء المهاجرين والأنصار بالثورة على الأمويين، وقد دفع ابن عفيف حياته على موقفه هذا. ولم تكن هذه الاعتراضات وحدها، بل هناك اعتراضات أخرى من داخل بيت ابن زياد، تمثّلتْ في تأنيب أمّه مرجانة له، وعدم رضى أخيه عثمان بن زياد على قتله الإمام الحسين×، واعتراض المختار بن أبي عبيد الثقفي في الأيّام التي تلت قتل ابن عفيف، وذلك عندما كرّر ابن زياد في خطبته النيل من الإمام الحسين× وشيعته، وقد أودعه ابن زياد في السجن لاعتراضه، ثمّ أخلى سبيله بتدخّل عبد الله ابن عمر وأمرِ يزيد بن معاوية. ولم يقتصر الرفض على الرجال، بل ما أن أُودِعُوا سبايا آل البيت^ السحنَ حتى هبّت نساء أهل الكوفة إلى ذلك السجن؛ لمواساة أهل البيت^، فأقيم أول مجلس عزاء على الإمام الحسين×.
وفي اليوم الثالث عشر من المحرّم أمر ابن زياد بالطواف برأس الإمام الحسين× وبقية الرؤوس في شوارع الكوفة، وبعد الانتهاء من ذلك أمر بنصبها على الخشب في باب مسجد الكوفة الأعظم.
وفي ليلة الخامس عشر من محرم وجّه ابن زياد السبايا إلى الشام، بعد أن جهّزهم والرؤوس معهم، وأصحبهم بعدد من قادة وأفراد جنده، وكان ذلك بطلب من يزيد بن معاوية، أو خشية ابن زياد من تفاقم الأمر في الكوفة لبقاء سبايا أهل البيت^ مدّة أطول فيها.
وبهذا ومع مرور هذه الأيّام الثلاثة الثقيلة على أهل البيت^ من النساء والصبيان، فقد بدأت لهم مرحلة أخرى من المعاناة في السير إلى الشام، عبر طريق طويل تخلّله البوادي والمُدن، وتَفَرّج النّاس عليهم. وهذا ما سنفصّله في الفصل القادم.
الفصل الثالث
سبي آل البيت^
من الكوفة إلى بلاد الشام
المبحث الأول: الأمراء الذين رافقوا سبايا آل البيت^ إلى الشام
المبحث الثاني: الطرق بين الكوفة ودمشق
المبحث الثالث: مسير سبايا آل البيت^ من الكوفة إلى دمشق
المبحث الرابع: استعراض سبايا آل البيت^ في دمشق
الفصل الثالث: سبي آل البيت ^ من الكوفة إلى بلاد الشام
الأمراء الذين رافقوا سبايا آل البيت^ إلى الشام
لقد أشارت الروايات التاريخية إلى عدد من الأمراء الذين رافقوا سبايا آل البيت^، وأوصلوهم إلى دمشق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى اختلفت الروايات في أيّهم أُرسل إلى الشام أولاً، هل هو رأس الإمام الحسين× وحده، أم رأس الإمام الحسين× ومعه بقية رؤوس القتلى، أم سبايا آل البيت من النساء والصبيان ورأس الإمام الحسين× وبقية الرؤوس؟
أشار بعض المؤرِّخين إلى أنّ رؤوس الشهداء قد أُرسِلت مع سبايا آل البيت من الكوفة إلى بلاد الشام([747])، بينما أشار آخرون إلى أنّ رؤوس القتلى سبقت سبايا آل البيت إلى بلاد الشام([748])، وهناك مَن أشار إلى أنّ ابن زياد قد بعث رأسَ الإمام الحسين× أولا، وبعث بعده بقية رؤوس القتلى وسبايا آل البيت إلى الشام([749]).
ويبدو أنّ إرسال رأس الإمام الحسين× وحده أولاً؛ لنيل رضا يزيد بن معاوية على عبيد الله بن زياد، وتعزيز مكانته عنده. وأما إرسال رأس الإمام الحسين× مع بقية رؤوس القتلى، وإلحاق السبايا بهم في أحد مواضع الطريق فيما بعد، هدفه التمويه خشيةً من متابعة بعض الجماعات الرافضة لفعل بني أميّة. وربما تقوم بمهاجمة القافلة، وأخذ الرؤوس ودفنها، وتحرير سبايا آل البيت من السبي.
لقد كتب ابن زياد إلى يزيد بن معاوية يخبره بانتصاراته المزعومة التي حققها، بقتل الإمام الحسين بن علي÷ وآل بيته وأنصاره، وسبي عياله من الطفّ إلى الكوفة. ولما وقف يزيد على كتاب ابن زياد أعادَ إليه الجواب يأمره بحمل رأس الإمام الحسين× ورؤوس من قتل معه، وحمل ثقله وعياله إلى دمشق([750]).
لقد هيّأ ابن زياد سبايا آل البيت وجهزهم، وهم من النساء والصبيان، وأمر أن يغلّ علي ابن الحسين÷ بغلّ إلى عنقه، ومعهم رأس الإمام الحسين× وبقية رؤوس القتلى([751]). وقد أسلفهم أبو خالد ذكوان([752]) عشرة آلاف درهم ليتجهزوا بها للمسير([753]). ويبدو أنّ سبب استلاف ابن زياد الأموال، كان للضائقة المالية التي عاشها، من جراء تجييش الجيوش على الإمام الحسين× لقتله، ومن ثمّ سبي عياله، وبذل الأموال لكسب تأييد بعض النّاس في حربه مع الإمام الحسين× من خلال شراء ذممهم بإعطائهم الأموال.
لقد وجّه ابن زياد قافلة السبايا إلى الشام، وأصحبهم بما يَقرُب من ألف جندي حرساً لهم؛ تحسّباً لما يمكن أن يحدث أثناء سير قافلة السبايا في الطريق([754])، فضلاً عن تهيئة عدّة السفر من المراكب كالجمال([755]) والخيول والبغال، والمرافقين من غير العسكريين لهذا العدد الكبير الذي ضمّته القافلة([756]).
إنّ رواية ابن سعد التي نقلها عن عدد من الرواة عن الإمام علي بن الحسين÷، حدّدت الوقت الذي خرجت فيه قافلة السبايا من الكوفة إلى بلاد الشام بعد أن جُهِزوا نهاراً، ولم يتمكّنوا من الخروج من الكوفة إلّا بعد ذهاب شطر من الليل؛ لشدّة ازدحام النّاس المتجمّعين والباكين على سبايا آل البيت([757]).
وقد حُمِّلَ سبايا آل البيت ـ وهم: الإمام علي بن الحسين÷ وأخواته وعمّاته وباقي النساء والأطفال ـ على محامل بغير وطاء، وكذلك رأس الإمام الحسين×ورؤوس إخوته وأهل بيته وأنصاره، وساقوا الجميع من بلد إلى بلد، كما تُساق الأسارى الأجانب([758]).
لقد كان قرار ابن زياد في توجيه سبايا آل البيت^ إلى الشام؛ إمّا لخشيته من انقلاب الأوضاع عليه في الكوفة، أو تنفيذاً لأوامر سيّده يزيد بن معاوية بإرسالهم إليه. فاختار كلّ من محفز([759]) بن ثعلبة العائذي([760]) والشمر بن ذي الجوشن، وهما من أمراء جيشه البارزين، وكلّفهما بأن ينطلقا بثقل سبايا آل البيت، ورؤوس القتلى كلّها إلى يزيد بن معاوية في دمشق، ولمّا وصلا باب قصر يزيد رفع محفز صوته عاليّاً وقال: «جئنا برأس أحمق النّاس وألأمهم»([761]).
ويبدو أنّ رأس الإمام الحسين× أوّل من وصل إلى يزيد مع محفز بن ثعلبة. ويستبعد بعض المؤرِّخين صحبة الشمر بن ذي الجوشن لمحفز بن ثعلبة في قيادة قافلة سبايا آل البيت والرؤوس في مسيرتها إلى الشام([762]).
وأشارت روايات أخرى إلى أنّ ابن زياد قد كلّف أميراً آخر من أمراء جيشه، يُدعى زحر([763]) بن قيس الجعفي([764])، بحمل سبايا آل البيت ورأس الإمام الحسين× وبقية رؤوس القتلى، ومعه شخصان آخران، هما: أبو بردة بن عوف الأزدي([765])، وطارق بن أبي ظبيان الأزدي([766]) إلى بلاد الشام([767]). وقد سبق زحر بن قيس الجعفي برأس الإمام الحسين× إلى دمشق، ودخل على يزيد ودفع إليه كتاب ابن زياد([768]).
وأشار الدينوري([769]) إلى أنّ أمراء ابن زياد، الذين رافقوا سبايا آل البيت ورأس الإمام الحسين× وبقية رؤوس القتلى، هم: زحر بن قيس الجعفي، ومحفز بن ثعلبة العائذي، والشمر بن ذي الجوشن إلى بلاد الشام. وبهذا فإنّ الدينوري جمع الأمراء الثلاثة في رواية واحدة لأداء المهمّة التي كُلِّفوا بها، وأنّ رؤوس القتلى كانت مع سبايا آل البيت، وقد أرسلوا سويةً إلى بلاد الشام([770]).
وأشار أبو مخنف في إحدى رواياته إلى أنّ ابن زياد اختار زحر بن قيس الجعفي،ومعه أبو بردة بن عوف الأزدي، وطارق بن أبي ظبيان الأزدي وكلّفهم بحمل رأس الإمام الحسين× ورؤوس القتلى من أصحابه إلى يزيد بن معاوية، فخرجوا لينفّذوا ما كلّفوا به حتى وصلوا بلاد الشام([771]).
وقد خلتْ هذه الرواية من أنّ سبايا آل البيت قد صحبوا الرؤوس. ويُؤيّد الطبري([772]) أبا مخنف في روايته هذه، وقد خالفهم ابن الأثير، حيث أشار إلى إرسال السبايا معهم إلى يزيد بن معاوية([773]).
وأشار فخر الدين الطريحي إلى أنّ ابن زياد كلّف الشمر بن ذي الجوشن وخولي ابن يزيد الأصبحي وشبث بن ربعي وعمرو بن الحجاج([774])، وهم من أمرائه البارزين في معركة الطفّ، وضمّ إليهم ألف فارس، وزوّدهم بما يحتاجونه في الطريق، وأمرهم بإيصال سبايا آل البيت ورؤوس القتلى إلى يزيد بن معاوية في دمشق([775]). وكان خولّي بن يزيد الأصبحي يقود قافلة سبايا آل البيت، ومعهم رأس الإمام الحسين× في مواضع بلاد الشام([776]).
وممّا تقدّم نخلص إلى أنّ هناك أكثر من أمير من أمراء جيش ابن زياد، ومعهم جيش يقدّر بألف جندي، قد رافقوا قافلة السبايا حراسةً لها من الكوفة إلى بلاد الشام، كلّفهم ابن زياد لأداء هذه المهمّة الشاقّة؛ لثقته بهم، ولحماية القافلة من أيّ اعتداء قد تتعرّض له في سيرها في طريق طويل، غير مضمون التأييد لفعل بني أميّة.
وقد أُخرِج رأس الإمام الحسين× من الكوفة وحده أولاً محاطاً بحراسة مشدّدة؛ للتمويه على النّاس خشيةً من ردود أفعالهم، ثمّ لحقت بهم قافلة السبايا في أحد مواضع الطريق، وسار الجميع إلى بلاد الشام، وعند وصولهم مدينة دمشق أُدخِل رأس الإمام الحسين× أولاً إلى يزيد بن معاوية في قصره، وذلك في الأول من صفر سنة 61هـ/681م([777])، وأُدخِل سبايا آل البيت إليه بعد ثلاثة أيّام، لاستكمال استعدادات الاستعراض الكبير الذي أمر به يزيد.
إنّ الهدف من إدخال رأس الإمام الحسين× أولاً إلى يزيد؛ لنيل التقرّب منه من قِبَل ابن زياد، وتعزيز مكانته عنده، وتبشيره بالنصر المزعوم. ولهذا السبب فإنّ أمراء ابن زياد قد قُسّموا لأداء مهامهم، فمنهم مَن حمل رأس الإمام الحسين×، ومنهم مَن حمل بقية الرؤوس وسبايا آل البيت.
ثمّ إنّ رؤوس القتلى، بما فيهم رأس الإمام الحسين×، قد وُضِعت ـ عمدا ـ بين محامل ركب السبايا على رماح طويلة؛ ليكون التفرّج على حرم رسول الله أكثر من قبل النّاس في شوارع دمشق، وهذا ما كان أيضا يحصل في حركة سيرهم بين المدن والقرى في الطريق الطويل من الكوفة إلى بلاد الشام، حيث كان يُوضع رأس الإمام الحسين× في صندوق، ويخرجونه عندما يريدون ذلك.
عرضنا فيما الروايات التاريخية التي أشارت إلى سبي آل البيت^من الكوفة إلى بلاد الشام، حيث كانوا في قافلة كبيرة قادها عدد من أمراء ابن زياد البارزين وجيشهم، إلّا أنّ تلك الروايات لم تشر إلى الطريق الذي سلكته تلك القافلة، باستثناء روايات أبي مخنف التي بيّنت لنا الطريق الذي سلكته قافلة سبايا آل البيت.
وفي الوقت ذاته لا بدّ من القول أنّ ما ذكره أبومخنف (ت157هـ/773م) لم تذكره روايات المؤرِّخين الذين جاءوا بعده، ممّا جعل الشكّ يحوم حول رواياته، وكل ما أشارت إليه روايات ما بعده عبارة عن إشارات جزئية غير كافية ومتفرّقة، تتناول حدثا ما حدث في ذلك الموضع أو تلك المدينة أو القرية. لذا وجب على الباحث الاستقراء([778]) للنصوص والروايات المتعلّقة بهذه المرحلة من مسيرة سبايا آل البيت^؛ من أجل معرفة الطريق الذي سلكته قافلة السبايا من الكوفة إلى بلاد الشام، وما حدث فيه من أحداث. ثمّ إنّ هناك ثلاث طرق بين الكوفة وبلاد الشام، سنتطرق إليها في المبحث القادم؛ لمعرفة أي طريق سلكته قافلة السبايا.
لقد كانت هناك ثلاثة طرق بين الكوفة ودمشق، وإنّ لكلّ طريق من هذه الطرق فروعاً عديدة، قصيرة أو طويلة في بعض مراحلها، وهي عبارة عن شبكة من الطرق تُوصل بعضها ببعض.
أولاً: طريق البادية (طريق البريد)
يمتدّ هذا الطريق من الكوفة إلى دمشق([779])، ويُعدّ من أقصر الطرق مقارنةً مع الطرق الأخرى، ولم يُسلك هذا الطريق إلّا من قبل الذين يمتلكون الإمكانيّات الكافية ليجتازوا المسافة الطويلة بين منازل الطريق الصحراوي المتباعد.
ومحطّات هذا الطريق من
الكوفة إلى دمشق تبدأ من الحيرة([780]) إلى القطقطانة،
إلى الأبيـض([781])، إلى الحُوشـي([782])، إلى الجمع([783])، إلى الخُطي
(خطا)([784])، إلى الجُبّة([785])، إلى الساعدة([786])، إلى البقيعة([787])، إلى الأعناك([788])، إلى أذرعات([789])،
واستمر بهم المسير إلى منزل([790])، ثمّ إلى دمشق([791]).
سُمّي هذا الطريق بهذا الاسم؛ لأنّ مُدُنَه تقع بمحاذاة نهر الفرات. ويكون الماء في متناول أيدي الذين يسلكون هذا الطريق وعلى ضفاف هذا النهر للسفر إلى شمال العراق والشام، ، ويستفيدون من المدن الواقعة على ضفاف الفرات أيضا؛ ولذلك كانت الجيوش الكبيرة والقوافل التي هي بحاجة إلى كميّات كبيرة من الماء مضطرّة لسلوك هذا الطريق.
ويبدأ هذا الطريق من الكوفة نحو الشمال الغربي بمسافة طويلة، وينحدر من هناك نحو الجنوب، وينتهي إلى دمشق بعد اجتيازه عدداً من مدن الشام. وكان لهذا الطريق تفرّعات عديدة يرتبط بها مع طرق أخرى، ولعلّه البديل المناسب لطريق البادية؛ لكثرة المياه في مواضعه.
ومن المنازل المهمّة في هذا الطريق، والذي يبدأ من الكوفة هي: هيت([792])، عانة([793])، آلوســة([794])، قرقيسيا([795])، الرقّة([796])، حِمـص([797])، دمشق([798]).
وتكثُر في هذا الطريق تجمّعات سكانية صغيرة شبه بدوية، غير ذات شأن ولا حضور سياسي أو اجتماعي أو ثقافي لها بنظر السلطة الأموية، ولا فائدة في استعراض السبايا فيها، بل قد يُستثمر ضد السلطة، وذلك من خلال إبلاغ السبايا لرسالة الطفّ والتأثير في ساكني هذه المناطق.
ثالثاً: طريق دجلة (الطريق الشمالي)
من الحقائق الجغرافية المعروفة أنّ نهر دجلة لا يمرّ ببلاد الشام، فكان مَن يريد السفر إلى شمال شرقي العراق يمكن أن يسلك ضفاف هذا النهر، ولم يكن هذا الطريق هو الطريق الرئيسي بين الكوفة ودمشق، فإنّ الذي يريد أن يسلك هذا الطريق فعليه أن يسير مقداراً منه، ثمّ ينحرف تدريجياً نحو الغرب، والالتحاق بطريق ضفاف الفرات بعد اجتياز مسافة ليست بالقصيرة، ثمّ يدخل دمشق من ذلك الطريق.
ومن أهمّ منازل هذا الطريق:
الكوفة، ومنها إلى شاهي([799])، ومنها إلى
القناطر([800])، ومنها
إلى اليعقوبية([801])، ومنها
إلى سوق أسد([802]) ومنه إلى
قصـر ابن
هبيرة([803]) ومنه إلى
بيزيقيا([804])، ومنها
إلى جسـر كوثي([805])، ومنه
إلى نهر الملك([806])،
ومنه إلى جـسر صرصر([807])، ومنه إلى مدينة السلام
(بغداد)([808])، ومنها إلى البردان([809])، ومنها إلى عكبرا([810])، ومنها إلى باحمشا([811])، ومنها إلى القادسيّة([812])، ومنها إلى سرّ مَن رأى([813])،
ومنها إلى الكرخ([814])، ومنها
إلى جبلتا([815])، ومنها
إلى السودقانية([816])، ومنها
إلى بارِمّا([817])، ومنها
إلى السِنّ([818])، وفيه
الزاب الأسفل، ومنه إلى الحديثة([819])، وفيها
الزاب الأعلى،
ومنها إلى مدينة الموصل([820])، ومنها إلى بلد([821])، وهنا يتفرّع الطريق إلى فرعين: أولهما: باتجاه تلعفر([822])، ومنه إلى سنجار([823]). وثانيهما: إلى باعيناثا([824]) ومنها إلى برقعيد([825])، ومنها إلى أذرمة([826])، ومنها إلى نصيبين([827])، ومنها إلى دارا([828])، ومنها إلى كفر تُوثا([829])، ومنها إلى قصر بني نازع([830])، ومنه إلى امد([831])، ومن امد طريق يتّجه نحو الجنوب الغربي إلى الرُها([832])، ومنها ينحرف الطريق جنوباً إلى حرّان([833])، ومنها ينقسم الطريق إلى اتّجاهين: أولهما: يتّجه غرباً إلى سَرُوج([834])، ومنها إلى جسر منبج([835])، ومنه إلى حَلَب([836])، ومنها إلى قِنَّسـرين([837])، ومنها إلى حمص، ومنها إلى دمشق([838]). وثانيهما: يتّجه جنوباً مع ضفّة نهر البليخ الشرقية، إلى منزل باجَروان([839])، ومنها إلى الرقّة([840])، والتي كانت مفترقا لعدّة طرق باتّجاه الشام والجزيرة الفراتية([841]).
بعد أن استعرضنا المواضع التي تمرّ بها الطرق الثلاث بين الكوفة وبلاد الشام، وحاضرتها دمشق، لا بدّ من التساؤل عن الطريق الذي سلكته قافلة سبايا آل البيت عند نقلهم من الكوفة إلى دمشق، هل هو طريق البادية، أو طريق الفرات، أو طريق دجلة؟
من خلال ما كان يهدف إليه الجهاز الحاكم الأموي من اطلاع أكثر سكّان المدن والقرى ـ وهي في الأعم الأغلب آهلة بالسكان ـ على سبايا آل البيت، ورؤوس قتلاهم، وفي مقدّمتهم رأس الإمام الحسين×، الذي يمثّل ما يمثّله في العالم الإسلامي من قدسية، كونه ابن بنت النبي’، ولا يوجد ابن بنت نبي في المشرق والمغرب غيره؛ ليكون عبرة لكلّ مَن يريد الوقوف ضد بني أميّة والثورة عليهم.
وهذا ما أشار إليه ابن أعثم،
حيث ذكر أنّ أمراء ابن زياد قد ساروا بحُرم
رسول الله من الكوفة إلى بلاد الشام من بلد إلى بلد، ومن منزل إلى منزل([842])، وهذا
يعني وجود عديد من المحطّات والمواضع في الطريق الذي سلكوه، وإنّ السبايا أخذوهم
في الطريق الشمالي إلى الموصل، أي طريق دجلة ومنها إلى حلب، ثمّ إلى دمشق. وهذا
الطريق الطويل تخلّلته المرتفعات والبوادي.
وممّا يُعزّز هذا القول ما جاء في خطبة زينب بنت علي÷، حيث تصوّر سير سبايا آل البيت ولاسيما النساء في مجلس يزيد بن معاوية في دمشق، عندما قالت له: «... ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل... »([843]). والمناهل مفرده: منهل، أي الماء الذي ينزل عنده المسافرون للتزوّد منه([844]). وأمّا المناقل فمفرده: منقل، أي الطريق عبر الجبال([845]).
ويتّضح من هذا القول أنّ الطريق الذي سلكوه هو عبر الجبال، والمواضع التي يتوقّفون فيها للتزوّد منها بالماء، وعندها يُستبعَد طريقا البادية والفرات، مع قصرهما بالمقارنة مع طريق دجلة.
وقد حدّد أبو مخنف في رواياته الطريق الأخير الذي سار به سبايا آل البيت ومعهم رؤوس القتلى، وذكر جملة من الأحداث التي حصلت عند مرورهم في مواضع هذا الطريق من مدن وقرى([846]).
مسير سبايا آل البيت ^ من الكوفة إلى دمشق
إنّ ما يلاحظ على المصادر
التي وصفت لنا دخول سبايا آل البيت الكوفة، واستعراضهم في شوارعها من قِبَل السلطة
الأموية، وخطبهم بين حشود أهل الكوفة، ودخولهم مجلس ابن زياد، وقضائهم مدّة قصيرة
في الكوفة لا تتجاوز ثلاثة أيّام، من ليل الثاني عشر إلى ليل الخامس عشر من المحرم
سنة 61هـ/681م؛ أنّها
ـ أي تلك المصادر ذاتها ـ لم تُفصّل لنا
عن ما حدث من حوادث لقافلة سبايا آل البيت في طريق سيرها إلى دمشق، إلّا إشارات
بسيطة هنا وهناك، سنذكرها تباعا.
بعد أنِ اتّخذ ابن زياد قراره بإرسال سبايا آل البيت ورؤوس القتلى إلى يزيد بن معاوية في دمشق، واتّخذ إجراءات عدّة لتحقيق ذلك؛ غادرت قافلة السبايا من الكوفة فجرَ يوم الخامس عشر من المحرّم أو قبل الفجر، وذلك للازدحام الشديد من قبل المتجمّعين من أهالي الكوفة([847]).
ولم تسلك قافلة السبايا الطريق المعتاد المتّجه إلى الشمال؛ وذلك لأنّ ابن زياد وأعوانه كانوا يخشون من ردود الأفعال في الكوفة التي كانت تغلي كالمرجل بأهلها، لذلك اتّجهت قافلة السبايا نحو القادسيّة التي تقع جنوب الكوفة([848])؛ وذلك للتمويه على النّاس من أن ابن زياد قد أرجعهم إلى المدينة، باعتبار أنّ هذا الطريق يُؤدّي بمَن سلكه إلى المدينة([849])، وبالتالي حتى لا يلحق بهم أحد لتخليص الرؤوس والسبايا. وهكذا تمّ اجتماعهم في القادسيّة، وهي أول بريّة، ثمّ اتّجهوا بعد ذلك شمالاً في طريق صحراوي دائري بعيداً عن الكوفة والمواضع القريبة منها، حيث الطريق الذي تسلكه القوافل المتّجهة نحو الشمال، وبهذا تجنّبوا المواضع الآهلة بالسكّان؛ لأنّه من المتوقّع وصول أصداء معركة الطفّ من قتل الإمام الحسين× ورجال بيته وأنصاره وسبي عياله إلى مسامعهم، الأمر الذي سيجعل تمويهات السلطة وخداعها للناس عن حقيقة الضحايا أمراً في غاية الصعوبة، فضلاً عن احتمال حصول أعمال انتقامية من قبل النّاس الغاضبين، خصوصا وأنّ قافلة السبايا تمرّ على مواضع من مدن وقرى عدّة منها موالية لأهل البيت^.
ويبدو أنّ ابن زياد ـ وهو من الإداريين الأمويين البارزين في خبرته الإدارية وحزمه ـ قد اتّخذ هذه الإجراءات من تلقاء نفسه في إرسال السبايا ورؤوس القتلى، وانسجمت مع أمر يزيد بن معاوية في توجيه السبايا ورؤوس القتلى إليه في دمشق وعبر طريق دجلة.
لقد عانى سبايا آل البيت^ في طريق سيرهم الطويل من الكوفة إلى الشام معاناة كبيرة، فقد غُلّ الإمام علي بن الحسين÷ بغلّ إلى عنقه، وهو يعاني المرض الشديد([850])، كما أنّه لم يكلّم أحداً من الرجال المصاحبين للقافلة بكلمة طوال مدّة سبيهم في الطريق إلى الشام([851])، وقد اركبوه على بعير يضلع([852])، أي: أعرج بغير وطاء، وإنّّ البعير الأعرج يؤذي راكبه، هذا ورأس الإمام الحسين× على علم، أي: على رمح طويل، ونساء أهل البيت(عليهن السلام) خلف الإمام علي بن الحسين÷ على بغال أكفّ([853])، والفارطة([854])خلفهم وحولهم بالرماح، أي أركبوهم على بغال ذات رحل صغير مع العجلة والسرعة من قبل أفراد جيش بني أميّة؛ بقصد إيذاء سبايا أهل البيت، ومن خلفهم يحملون الرماح، فإذا دمعت عين أحدهم ضربوا رأسه بالرمح، وعند دخولهم دمشق صاح صائح: إنّ هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون([855]).
كان في طريق دجلة عدد كبير من مواضع المدن والقرى مرّت بها قافلة سبايا آل البيت ورؤوس القتلى، وحدثت في بعضها أحداث سنمرّ بها. والمواضع هي ما يلي:
1 ـ دير([856]) سرجس وبكس([857])
بعد خروج قافلة السبايا من الكوفة متوجّهة جنوباً إلى القادسيّة، مرّت في طريقها على دير([858]) سرجس وبكس، إلّا أنّ بعض الباحثين يعتقد أنّ أوّل موضع نزلت فيه قافلة السبايا هو منزل خراب، وهو غير هذا الدير([859]). وإنّ اعتقادهم هذا جاء من أنّ هذا الدير كانت تحفّ به بساتين الكروم والأشجار، إلّا أنّه فيما بعد تحوّل إلى خراب.
وقيل: إنّ الجماعة التي حملت رأس الإمام الحسين× إلى دمشق وفي أول مرحلة جلسوا يشربون النبيذ، فخرج عليهم قلم من حديد من الحائط، وكتب سطراً بالدم:
|
أترجو أمّةٌ قتلت حسيناً |
فلمّا رأوا ذلك هربوا وتركوا الرأس ثمّ رجعوا([860]).
وجاء عن سليمان بن مهران الأعمش(ت148هـ/765م)([861]) أنّه كان أيّام الطواف في موسم الحج فإذا برجل يقول: «اللهمّ اغفر لي، وأنا أعلم أنّك لا تغفر، فسألته عن السبب، فقال: كنت أحد الأربعين الذين حملوا رأس الحسين إلى يزيد على طريق الشام، فنزلنا أول مرحلة رحلنا من كربلاء على دير للنصارى والرأس مركوز على رمح، وضعنا الطعام ونحن ناكل إذا بكفّ على حائط الدير يكتب عليه بقلم حديد سطراً بدم:
|
أترجو أمّةٌ قتلت حسيناً |
يُلاحظ من هذه الرواية أنّ رأس الإمام الحسين× قد أُرسِل أولاً بصحبة أربعين رجلاً إلى يزيد، وهم مسؤولون عن حراسته، وقد سبق خروجهم قافلة السبايا، بمعنى آخر: لم تكن سبايا آل البيت ولا بقية رؤوس القتلى معهم. وتُؤكّد الرواية أيضا أنّ أول منزل نزلوا فيه هو دير للنصارى وليس منزلاً خراباً. ثمّ إنّ بيت الشعر وطريقة كتابته تعدّ كرامة من كرامات سبط النبي’ الإمام الحسين بن علي÷.
وقيل: إنه وُجِد بيت الشعر هذا مكتوباً على أحد جدران كنائس الروم عند غزو المسلمين بلاد الروم، وسألوهم عن هذا البيت من الشعر ومَن الذي كتبه، فأجابوهم بأنّه كُتِب قبل أن يُبعث نبيكم بثلاثمائة عام([863])، وقيل: خمسمائة عام([864]).
لقد سارت قافلة السبايا من الكوفة، بجانب نهر الفرات إلى الجنوب قليلاً حتى وصلوا موضع القادسيّة.
وأشار الشيخ المفيد: إلى أنّ السبايا من النساء والأطفال قد سُيّروا مع محفز بن ثعلبة والشمر بن ذي الجوشن باتّجاه القادسيّة؛ ليلحقوا بالقافلة التي معها الرؤوس([865]). وتدلّ هذه الرواية على أنّ الرؤوس قد أُخرِجت قبل قافلة السبايا، والتحقوا بهم في القادسيّة.
وبعد ذلك ساروا سويةً وعبروا القادسيّة، وبدلاً من التوجّه نحو القطقطانة اتّخذوا من هنالك إلى الشام طريقاً صحراوياً دائرياً إلى الشمال. ويبدو أنّ أمراء القافلة كانوا يهدفون من وراء ذلك الابتعاد عن أعين النّاس، وانفصالهم عن الكوفة؛ خشيةً من القبائل العربية أن تخرج عليهم وتأخذ رأس الإمام الحسين× منهم([866])، فساروا حتى وصلوا إلى طريق القوافل المعتاد الذي يتّجه من الكوفة شمالاً إلى الموصل. ولا توجد رواية تُوضّح أنّ قافلة السبايا قد التحقت بهذا الطريق عند موضع شاهي، ولم تتوقّف فيه بل واصلت سيرها حتى عبرت القناطر إلى اليعقوبية، واجتازتها ومرّت على سوق أسد، ومنه إلى الموضع الذي يليه. وهذا ما أشار إليه أحد الباحثين([867]).
سارت قافلة السبايا والرؤوس مارّة بهذا الموضع([869])، وهي في طريقها نحو قصر ابن هبيرة، ويبدو أنّه يقع شرقي الحصّاصة.
وقد أشار أبو مخنف إلى أنّ قافلة السبايا عند وصولها إلى الحصّاصة سارت من شرقها ولم تتوقّف فيها، بل واصلت سيرها حتى وصلت تكريت([870]).
وأشار أحد الباحثين بأنّ قافلة السبايا عند اجتيازها الحصّاصة مرّت ببعض المواضع قبل وصولها إلى تكريت، مثل: بزيقيا، وهي في يومنا هذا تقع ضمن حدود محافظة بابل([871])، ثمّ وصلت إلى موضع كوثى، وبهذا فإنّ قافلة السبايا في يومنا هذا قد دخلت الحدود الإدارية لبغداد([872])، ثمّ وصلت القافلة نهر الملك وعبرت جسر صرصر، وعند اجتياز القافلة لهذا الموضع تكون قافلة السبايا قد اجتازت حدود بغداد([873]) ودخلت الحدود الإدارية لمحافظة صلاح الدين، مارة بمواضع حمارات([874])، ونهر الفرحاتية([875]) والمحادر([876]) ومهيجر([877])، كل ذلك قبل وصولهم إلى تكريت.
ومع ما ذُكِر من مواضع فإنّه لا توجد رواية تؤكّد مرور القافلة بها، ويبدو أنّ إشارة الباحثين إلى ذلك؛ لكون تلك المواضع تقع على الطريق الشمالي المؤدّي إلى الموصل، وهذا لا يكون دليلاً قاطعاً؛ لأن الأمراء المصاحبين لقافلة السبايا يسلكون في بعض الأحيان طُرقاً فرعية في البوادي عند انتقالهم من مدينة إلى أخرى، وممّا يؤكّد ذلك ما أشار إليه الجغرافيون والبلدانيون العرب والمسلمون، من أنّ أسماء هذه المدن لا تتطابق مع مسمّيات المدن الواقعة على هذا الطريق([878]). وربما تكون هذه المدن أنشئت فيما بعد، وهذا يعني أنّها غير موجودة إبّان سبي آل البيت.
قبل أن تصل القافلة إلى تكريت كتب أمراء القافلة إلى عاملها بأنْ يقوم باستقبالهم لأنّ معهم رأس خارجي، وعند قراءة عامل تكريت مضمون الكتاب أمر بنشر الأعلام والضرب بالأبواق، وتزيين مدينتهم، وجاء النّاس من كلّ جانب، وخرج عامل تكريت بنفسه في استقبال القافلة، وعند سؤاله عن الرأس قيل له هذا رأس خارجي؛ فخرج على يزيد بن معاوية، ثمّ قتله عبيد الله بن زياد والي الكوفة الأموي([880]).
وهذا يبيّن الأهداف الأموية من وراء تسيير سبايا آل البيت ورؤوس القتلى مروراً بهذه المواضع، إذ كانوا يهدفون إلى إقامة استعراض للسبايا والرؤوس في كلّ موضع يصلون إليه، ومحاولة التشهير بآل البيت والحطّ من قدسيتهم كلّما أمكنهم ذلك.
وقد اعترض رجل نصراني قائلاً: «يا قوم إنّي كنت في الكوفة، وقد قدم هذا الرأس، وليس هو رأس خارجي، بل هو رأس الحسين بن علي، فلمّا سمع النصارى ذلك ضربوا النواقيس إعظاماً له، وقالوا: إنّا برئنا من قوم قتلوا ابن بنت نبيّهم»([881]).
وما إن علم أمراء القافلة من كشف زيف ادّعائهم، وأنّ هذا الرأس ليس لخارجي، وصار معروفاً أنّه رأس الإمام الحسين×، وعمّ الرفض بين أهالي المدينة؛ غيّروا رأيهم، وعدلوا عن دخول المدينة، واتّجهوا إلى طريق البر.
ومن هذا يتّضح أنّ بني أميّة وأمراءهم كانوا يعتّمون على هوية السبايا في كلّ موضع تمرّ فيه القافلة، ولكن ما إن ينكشف أمرهم يسارعون بالابتعاد والتوجّه إلى طرق غير معروفة، كسيرهم في طرق برية تجنبّاً من ردود الأفعال، وبالتالي يبتعدون عن النّاس.
ولم يقتصر الرفض لهذه الجريمة على المسلمين فقط، بل نرى الأديان الأخرى ترفض هذا الفعل، لذا نجد نصارى تكريت يعلنون الحداد على الإمام الحسين×، وعلى مَن قُتِل معه من أهل بيته وأنصاره.
سارت قافلة السبايا حتى وصلت إلى وادي النخلة، فنزلوا فيها وباتوا تلك الليلة([883])، ومن وادي النخلة أخذوا على أرمينا، ويبدو أنّه موضع السن، ويُعرف في الوقت الحاضر بإسم الفتحة. ولم نجد موضعاً بهذا الاسم يقع على هذا الطريق، ولا توجد إشارة من أحد الجغرافيين والبلدانيين العرب والمسلمين باستثناء أحد الباحثين المعاصرين([884]).
ثمّ سارت القافلة ووصلت موضع البلاليق([885])، ومنها ساروا حتى وصلوا إلى لينا، وأشار أحد الباحثين المعاصرين إلى أنّ لينا هي نفسها اللين([886])، ولا يمكن قبول ذلك؛ لأنّ "لينا" وفق تعريف البلدانيين والجغرافيين بأنّها أكبر قرية من كورة([887]) ما بين النهرين، وتقع بين الموصل ونصيبين([888])، ولم نجد لها تعريفاً، فهي إمّا قد تغيّر اسمها، أو اندثرت فلم يعد لها وجود.
وعندما وصلت قافلة سبايا آل البيت^ إلى هذا الموضع الذي كان عامراً بالنّاس؛ خرج أهله شيوخاً وشباباً ينظرون إلى رأس الإمام الحسين×، ويصلّون على جدّه وأبيه، ويلعنون مَن قتله، وهم يقولون: «يا قتلة أولاد الأنبياء، أخرجوا من بلدنا»([889]). ويبدو أنّ أهالي هذه المدينة من الموالين لأهل البيت^؛ لذا لم يوافقوا على دخول القافلة قريتهم.
وأشار لبيب بيضون إلى أنّ قافلة السبايا وقبل دخولها إلى الكحيل([890]) مرّت ببلدة مرشاد، ثمّ بمدينة برساباد، وأنّ أهالي هذين الموضعين خرجوا بشيوخهم ونسائهم وشبانهم يتفرّجون على السبايا ورؤوس القتلى، ويصلّون على محمّد وآله، ويلعنون أعداءهم ومّن قتل الإمام الحسين×، وطردوهم من مدنهم([891]).
وعند الرجوع إلى المصادر التي نقل منها لبيب بيضون وجدنا أنّ هاتين المدينتين ـ وماجرى من حوادث على أرضيهما ـ تعودان إلى موضع لينا، فإنّه اقتطع الحوادث التي حدثت فيهما، ونسبها إلى مواضع أخرى ذكرها. كما إنّنا لم نجد لها ذكراً في المصادر الجغرافية والبلدانية للعرب والمسلمين أو غيرهم، كما لا يوجد موضع بإسم مرشاد، وبرساباد هي نفسها موضع لينا، وإنّ لبيب بيضون نقل هذه الرواية عن فخر الدين الطريحي([892]).
لقد سارت قافلة السبايا من لينا ووصلت الكحيل، واجتازوها سائرين باتجاه جُهينة([893])، وقد أشار لبيب بيضون، بأنّ قافلة السبايا بعد خروجها من جُهينة مرّت بعَسقلان([894]). وعند الرجوع إلى المصادر الجغرافية والبلدانية لم نعثر على مدينة بهذا الاسم سوى عَسقلان فلسطين الشام. كما أشار باحث معاصر آخر إلى أنّ قافلة السبايا عند خروجها من جُهينة، توجّهت إلى حمّام العليل([895])، ولم نجد هذا الموضع ضمن مواضع الطريق الذي مرّت به قافلة السبايا، ونعتقد أنّ حمّام العليل قد أُنشئ فيما بعد. وواصلت القافلة سيرها إلى الموضع الآخر.
بعد أن وصلت قافلة سبايا آل البيت^ عند مشارف الموصل، بعث أمراء القافلة رسولاً إلى عاملها يطلب منه الخروج لاستقبال القافلة وتهيئة الطعام لهم والعلف لحيواناتهم من الجمال والخيول، فقام عامل الموصل بتزيين مدينته ونشر الأعلام، وتجمّع الأهالي من كلّ جانب، وخرج بنفسه لاستقبال القافلة على بعد ستّة أميال، وعندما طرح النّاس السؤال لِمَن الرأس هذا؟ فأُجيبوا بأنّه رأس خارجي خرج بأرض العراق، فقتله عبيد الله بن زياد والي الكوفة الأموي، وبعث برأسه إلى يزيد بن معاوية، وظنَّ بعضهم بأنّه رأس الإمام الحسين×، فلمّا تأكّد عندهم ذلك اجتمعوا في أربعين ألف فارس من الأوس والخزرج، وقرّروا أن يقاتلوهم، ويأخذوا رأس الإمام الحسين× منهم ويدفنوه عندهم؛ ليكون فخراً لهم إلى يوم القيامة، ولمّا سمع أمراء القافلة بذلك قرّروا عدم دخول المدينة تجنّباً من الاصطدام بأهلها، وظلّوا على بُعد مسافة فرسخ عنها([897]).
المُلاحظ على هذه الرواية أنّها مبالغ فيها؛ حيث إنّ أربعين ألفاً ليس بالعدد القليل، ثمّ إنّهم لماذا لم يقوموا بمهاجمة القافلة وتخليص السبايا منهم؟! لذا نعتقد أنّ هذه الرواية يُراد منها إعطاء مكانة للأوس والخزرج.
وخلال المدّة التي كان ينتظر فيها أمراء بني أميّة دخول المدينة وضعوا رأس الإمام الحسين×على صخرة، فوقعت عليها قطرة من دم رأس الإمام الحسين×، فصارت هذه القطرة تشعّ وتغلي سنوياً يوم عاشوراء، وبقي هذا الأمر إلى عهد الحاكم الأموي عبد الملك بن مروان (65ـ86هـ/684ـ705م)، فأمر بنقل تلك الصخرة إلى مكان آخر، ولم يرَ بعد ذلك لذلك الأمر من أثر، ولكن فيما بعد بُنيَ على ذلك الموضع قبةٌ سُمّيت بمشهد النقطة([898]).
ثمّ واصلت القافلة سيرها حتى وصلت إلى أُسكي موصل (بلد)، وهنا يتفرّع الطريق إلى فرعين، أحدهما يذهب إلى باعيناثا، ومنها إلى برقعيد، ومنها إلى أذرمة، ومنها إلى تل فراشة، ومنه إلى نصيبين، إلّا أنّ قافلة السبايا لم تسلك هذا الطريق وإنّما اتجهت إلى تلعفر.
سارت قافلة السبايا حتى وصلت تلعفر ثمّ إلى جبل سنجار، وقيل فيه مشهد لعلي بن أبي طالب×، ويوجد فيها تلّ قنبر أيضاً([899]). وأشار أحد الباحثين إلى وجود مزار فيها لزينب بنت علي بن أبي طالب÷، ويقع على ربوة عالية في مدخل المدينة([900]). ونعتقد أن مشهد علي بن أبي طالب× أخذ يُعرف بمرور الزمن بإسم مزار السيّدة زينب‘.
وبعد أن عبرت قافلة السبايا جبل سنجار توجّهت نحو أراضي الجمهورية العربية السورية، وبهذا نكون قد انتهينا من المواضع التي مرّت بها قافلة السبايا داخل أراضي جمهورية العراق([901]).
إنّ وصول قافلة السبايا إلى نصيبين قادمة من جبل سنجار تكون قد دخلت أراضي جمهورية تركيا، مروراً بأراضي العربية السورية. وخلال مسير القافلة في هذا الطريق مرّت بمواضع لم تكن مثبّتة على طريق رحلة القافلة، لكنّها اليوم موجودة، لذا لم نجد أحداً من البلدانيين أو الجغرافيين العرب والمسلمين الأوائل يذكر هذه المواضع في مصنفاتهم. ومن هذه المواضع الخاتونية([903])، قصر الملك نرام سين، معبد العيون([904])، تل براك([905])، بئر الحلو([906])، خربة ظاهر([907])، تل الذهب([908])، الكيطة([909])، والقامشلي([910]).
وعند وصول القافلة إلى نصيبين نزلوا فيها وشهروا رأس الإمام الحسين×، وأُمِر عاملها منصور بن الياس([911]) بتزيين المدينة بالمرايا، وقد نشرت أكثر من ألف مرآة؛ وذلك لإعطاء أكثر من صورة للرؤوس والسبايا، وبالتالي يمكن رؤيتهم من جميع الاتجاهات. وأراد مَن كان يحمل رأس الإمام الحسين× أن يدخل المدينة فلم يستجب له فرسه، ولم يفلح في تبديل أكثر من فرس حتى سقط رأس الإمام الحسين× إلى الأرض، فأخذه إبراهيم الموصلي([912]) وعرفه بعد أن تأمّله كثيراً، بأنّه رأس الإمام الحسين×، فلم يرض على فعلهم هذا ممتعضاً وموبّخاً لهم، فقتلوه على موقفه هذا، وتركوا رأس الإمام الحسين× خارج المدينة، ولم يتمكّنوا من إدخاله([913]).
واصلت قافلة السبايا سيرها من نصيبين إلى عين الوردة([915])، ولمّا وصلت قريباً من دعوات كتب أمراء القافلة إلى عاملها بأن يخرج لاستقبالهم وأنّ معهم رأس الإمام الحسين×. وعندما قرأ عامل دعوات الكتاب أمر بضرب الأبواق وخرج لاستقبالهم، وشهروا الرأس ودخلوا من باب الأربعين، ونصبوا رأس الإمام الحسين× في الرحبة من زوال الشمس إلى العصر والنّاس طائفة في حزن يبكون، وأخرى في فرح يضحكون. وفي تلك الرحبة التي نُصِب فيها رأس الإمام الحسين× لا يجتاز فيها أحد إلّا وتُقضى حاجتُه إلى يوم القيامة.
ويبدو أنّ هذا الموضع لم تكن فيه معارضة لأمراء القافلة؛ لذلك باتوا تلك الليلة ثملين من شربهم الخمور إلى الصباح، ورحلت القافلة غداة اليوم التالي([916]).
واستمرت قافلة السبايا بالسير حتى وصلوا إلى قنسرين.
وأشار باحثان معاصران إلى أنّ قافلة السبايا قد مرّت على عدد من المدن قبل دخولها قنسرين، وتلك المدن هي: حران، ولاية شان لورفا (مدينة الرها قديماً)، الرقّة، قلعة دوسر([917])وبالس([918]).
توجهت قافلة السبايا إلى مدينة حلب، واستمرّت بالمسير حتى وصلت إلى جبل الجوشن([919])، سُمّيَ بهذا الاسم نسبة إلى الشمر بن ذي الجوشن، وهو الذي تولّى ذبح الإمام الحسين×، وكان من بين الذين اقتادوا الرؤوس والسبايا والتشهير بهم في البلدان. وفي هذا الموضع أُنزل السبايا على مسافة من مكان الرؤوس وبقي في هذين الموضعين بعد الارتحال أثران مهمان، الأول: نقطة من دم الإمام الحسين× سقطت من رأسه على الحجر الذي وضع عليه الرأس، والثاني: قبر محسن بن الحسين× الذي أسقط من إحدى زوجات الإمام الحسين× التي كانت حاملاً به، أثناء مبيت السبايا، وقد بُني عليه مشهد السقط([920]) أو مشهد الدكة([921]).
ومن مدينة حلب توجهت القافلة إلى مدينة قنسرين. ومن الجدير ذكره أن أبا مخنف لم يشر عند مرور قافلة السبايا لهذه المواضع، بل أشار على أنّ القافلة بعد أنْ خرجت من دعوات ساروا حتى وصلوا قنسرين([922]).
ولما بلغ خبر وصول سبايا آل البيت^ أهالي مدينة قنسرين وهي عامرة بأهلها قاموا بغلق أبواب المدينة، وبدأوا يلعنون أمراء القافلة، ويرمونهم بالحجارة ويقولون لهم: «يا فجرة يا قتلة أولاد الأنبياء، والله لا دخلتم بلدنا، ولو قُتلنا عن آخرنا»، فرحلوا عن المدينة ولم يدخلوها([923]).
وهكذا فإنّ حالة الرفض والاستياء كانت واضحة لدى أهالي قنسرين من المسلمين وغيرهم لأمراء بني أميّة، لدرجة أنّهم كانوا مستعدين للموت لمنعهم من دخول مدينتهم.
وأشار الخوارزمي إلى رجل يهودي في مدينة قنسرين نزلت عنده قافلة السبايا عند وصولها المدينة ليلاً، فشربوا وسكروا، وأثناء مبيتهم تلك الليلة عنده أخبروه بأنّ معهم رأس الإمام الحسين×فطلب منهم رؤيته، فأروه الرأس وهو في صندوق يسطع النور منه إلى السماء، فأصاب اليهودي العَجب من ذلك، وطلب الرأس منهم فأعطوه إيّاه، وهنا خاطب الرأس وهو بتلك الحال قائلاً: «إشفع لي عند جدّك، فأنطق الله تعالى الرأس مجيباً على قول اليهودي قائلاً: إنّما شفاعتي للمحمّديين ولست بمحمّدي، فجمع اليهودي أولاده وأقرباءه، وأخذ الرأس ووضعه في طشت وصبّ عليه ماء الورد مخلوطاً بالكافور والمسكّ والعنبّر، وقال لهم: هذا رأس ابن بنت محمّد، والهفاه لم أجد جدّك محمّداً فأسلم على يديه، ثمّ والهفاه لم أجدك حيّاً فأسلم على يدك وأقاتل دونك، فلو أسلمت الآن أتشفع لي يوم القيامة؟ فأنطق الله تعالى الرأس بلسان فصيح: إن أسلمت فأنا لك شفيع، قالها ثلاث مرّات، فأسلم الرجل ومَن كان معه»([924]).
وصلت قافلة السبايا إلى معرة النعمان فاستُقبِلوا من قِبَل أهلها، وفتحوا لهم أبواب مدينتهم، وقدّموا لهم المساعدات من الطعام والشراب، وبقوا فيها بقية يومهم ثمّ رحلوا عنها([926]).
14 ـ شيزر([927]) (سيبور)
استمرّ سير قافلة السبايا حتى وصلوا شيزر، ويبدو أنّ لهذه المدينة اسماً آخر هو سيبور، الذي لم نجد له تعريفاً في مصادرنا الجغرافية والبلدانية التي اطّلعنا عليها، وربما تغيّر اسمها بسبب التصحيف.
وكان في هذه المدينة شيخ كبير مِمَّن رأى عثمان بن عفّان، جمع أهل المدينة من الشيوخ والشبّان، وأخبرهم بأنّ هذا هو رأس الإمام الحسين× قتله هؤلاء اللعناء، وعندها رفض المتجمّعون اجتياز القافلة مدينتهم، ولم تُجدِ محاولات ذلك الشيخ عندما رأى تأزم الأمر من ثني أهالي المدينة عن ذلك، فقطعوا قنطرة النهر الذي يمرّ في وسط المدينة، وخرجوا بسلاحهم وقاتلوا حرس القافلة قتالاً شديداً، وقُتِل من أصحاب خولّي بن يزيد الأصبحي ستمائة فارس، ومن أهالي المدينة خمسة فرسان. ودعت زينب لأهل هذه المدينة قائلةً: «أعذب الله شرابهم، ورخّص الله أسعارهم، ورفع أيدي الظلمة عنهم»([928])، ولمّا وجدوا أمراء القافلة ذلك الموقف من الأهالي تركوا المدينة ولم يدخلوها([929]).
ويلاحظ أنّ هناك مبالغة في عدد قتلى أصحاب خولّي بن يزيد الأصبحي، وأنّ ما جاء من دعاء السيّدة زينب لأهالي هذه المدينة إنّما هو تثميناً لموقفهم في الثبات على الحقّ، ورفضهم أفعال بني أميّة.
سارت القافلة إلى كفر طاب، وكان حصناً صغيراً أغلق أهله بابه، ولم يسمحوا لهم بدخول مدينتهم، وطلب خولّي بن يزيد الأصبحي منهم الماء، فأجابوه بأنّ مَن منع الإمام الحسين× وأصحابه من شرب الماء لا نُسقيه قطرة واحدة([931])، وموقفهم هذا يُعدّ رفضاً واضحا لأفعال بني أميّة وأعوانهم.
لمّا وصلت قافلة السبايا مدينة حَماة قام أهلها بغلق أبوابها في وجوههم، وركبوا ستور مدينتهم، ومن فوقه نادوا المكلّفين بقيادة قافلة سبايا آل البيت، وأقسموا لهم بالله تعالى بأنّهم لن يسمحوا لهم بدخول المدينة ولو أدّى ذلك إلى قتلهم جميعاً([933]).
وهذا يبيّن مدى رفض أهالي حَماة لفعل بني أميّة وأعوانهم، لدرجة أنّهم كانوا على استعداد إلى القتال، وإلى أن يُقتَلوا بأجمعهم.
عندما لم يجد أمراء وأفراد الجيش المرافق للقافلة أيّ استجابة من أهالي حماة، من فتح الأبواب وتقديمهم ما يحتاجون إليه؛ توجّهت القافلة ومَن معها إلى موضع الرستن([934]) ـ وهو يقع ضمن حدود مدينة حمص ـ وعلى مشارفه كتبوا إلى عاملها خالد بن النشيط([935])، يخبرونه بأنّ معهم رأس الإمام الحسين×، وعند ذلك أمر خالد بنشر الأعلام وتزيين المدينة، ثمّ خرج لاستقبال القافلة، وعلى بُعد ثلاثة أميال تجمّع النّاس من كلّ مكان، وانضمّ عامل الرستن وأهلها إلى أمراء وأفراد الجيش الأموي، وشهروا رأس الإمام الحسين×، واتّجه الجميع إلى حمص ودخلوا بابها، وازدحمت النّاس فيه، ومنعهم أهل حمص وتمكّنوا من غلق الباب في وجوههم، ورموهم بالحجارة، فقُتِل ستّة وعشرون فارساً، وقالوا لهم: «يا قوم أكفر بعد إيمان، وضلال بعد هدى»([936])، فتراجعوا ووقفوا إلى جانب كنيسة قسيس، وهي دار لخالد بن النشيط.
واتّفق أهل حمص على أن يقتلوا خولّي بن يزيد الأصبحي، ويأخذوا رأس الإمام الحسين× منهم؛ ليكون فخراً لهم إلى يوم القيامة([937])، وخشية من وقوع ذلك قرّر أمراء القافلة الابتعاد عن المدينة والخوف ينتابهم، واتّجهوا نحو الغرب (لبنان).
ولعلّ توجّههم نحو هذا الطريق؛ لأنّه مؤمّن عسكرياً على عكس الطريق المستقيم من حمص إلى دمشق([938])، أو لربّما أرادوا أن يأتوا دمشق من جانبها الغربي الذي يسكنه المسيحيون.
بعد أن تقدّمت القافلة من حمص مرّت بمواضع الجوسية([940]) واللبوة([941])، وهي متّجهة إلى بعلبك، ولمّا صارت على مشارفها كتب الأمراء إلى عاملها يخبرونه بأنّ معهم رأس الإمام الحسين×، فأقام عامل بعلبك احتفالاً كبيراً، وأمر بنشر الأعلام والضرب بالأبواق والجواري يضربن بالدفوف، وقدّم لأمراء القافلة ومَن كان معهم من أفراد الجيش الخلوق([942]) والسكر والسويق، وبات الجميع تلك الليلة ثملين.
وهنا سألت السيّدة زينب قائلة: «ما يُقال لهذه البلدة؟ فقالوا: لها بعلبك. فدعت على أهلها قائلةً: أباد الله خضراءهم، ولا أعذب الله شرابهم، ولا رفع أهل أيدي الظلمة عنهم»([943]).
19 ـ صومعة([944]) الراهب([945])
بعد أن قضت قافلة السبايا مبيتها ليلة واحدة في بعلبك قرّر أمراؤها الرحيل عنها صباحاً والتوجّه إلى دمشق، وفي الطريق اجتازوا موضع معربون([946]). وبهذا تكون قافلة السبايا قد غادرت الأراضي اللبنانية([947]) ودخلت الأراضي السورية.
واستمروا في سيرهم حتى أدركهم المساء عند صومعة راهب فنزلوا إلى جانبها([948]). وعندما جنّ الليل وضع رأس الإمام الحسين× إلى جانب الصومعة، ولمّا عسعس الليل سمع الراهب دويّاً كدويّ الرعد، وتسبيحاً وتقديساً، واستأنس بالأنوار الساطعة الطالعة، وأخرج الراهب رأسه من الصومعة، فنظر إلى باب قد فُتِحت من السماء والملائكة ينزلون جماعات جماعات، ويسلّمون على رأس الإمام الحسين×قائلين: «السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله. وهنا جزع الراهب جزعاً شديداً، ولمّا بزغ الصباح همّ أمراء القافلة بالرحيل، فسألهم عن الذي معهم؟ فأجابوه بأنّه رأس خارجي خرج بأرض العراق، قتله عبيد الله بن زياد والي الكوفة الأموي، وسألهم مرّة أخرى عن اسمه، فأجابوه بأنّه الحسين بن علي بن أبي طالب، وأمّه فاطمة الزهراء، وجدّه محمّد رسول الله، فذمّهم الراهب وبشرهم بالويل والعذاب، وأكّد على قول أنّ السماء ستمطر دماً عند قتل نبي أو وصي نبي، وطلب من زعيمهم خولّي بن يزيد الأصبحي إبقاء الرأس ساعة واحدة عنده وسيردّه إليهم، وأجابه خولّي بن يزيد الأصبحي بأنّه لا بدّ من تسليم الرأس إلى يزيد بن معاوية ونيل الجائزة منه، ولمّا أحضر الراهب لهم مقدار المال المساوي لجائزة يزيد وسلّمه إليهم؛ دفعوا إليه الرأس وهو على الرمح، فأنزله الراهب وقبّله وبكى عليه، وكان يعزّ عليه أن لا يواسيه بنفسه، وخاطب الرأس قائلاً: «يا أبا عبد الله، إذا لقيت جدّك رسول الله فاشهد لي، أنّي أشهد أن لا اله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً رسول الله»([949]).
ولمّا أرجع الراهب إليهم الرأس سارت القافلة، وفي الطريق أرادوا تقسيم الدراهم بينهم وإذا هي بأيديهم خزف مكتوب عليها: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)([950])، وعندها أوصى خولّي بن يزيد الأصبحي مَن كان معه في القافلة بكتمان خبر ما حدث؛ لأنّه يعدّه خزياً بين النّاس([951]).
وأشار سبط بن الجوزي في رواية أخرى إلى أنّ حَمَلَة الرؤوس ومعهم أسارى وسبايا آل محمد^ توقفوا عن السير عندما حلّ الليل إلى جانب أحد الأديرة، وفي منتصف الليل رأى راهب الدير نوراً من مكان رأس الإمام الحسين× إلى عنان السماء، وعند ذلك سألهم من أين أنتم؟ فأجابوه بأنّهم من أصحاب ابن زياد، وسألهم ثانيةً عن الرأس، فأخبروه بأنّه رأس الحسين بن علي بن أبي طالب بن فاطمة ابنة رسول الله([952])، فقال لهم: «ابن نبيّكم»([953])؟ فأجابوه بنعم، فقال لهم: «بئس القوم أنتم، لو كان للمسيح ولد لأسكنّاه أحداقنا»([954])، ثمّ طلب منهم الرأس ليبق عنده تمام هذه الليلة مقابل إعطائهم عشرة آلاف دينار وإرجاعه عند رحيلهم في الصباح، فوافق أمراء قافلة السبايا على ذلك، وقبضوا الأموال، وأخذ الراهب رأس الإمام الحسين× وغسله وطيّبه، وجلس تلك الليلة كلّها باكياً عنده، ولمّا حان الصباح قال للرأس: «لا أملك إلّا نفسي، وأنا أشهد أن لا اله إلّا الله، وأنّ جدّك محمّداً رسول الله، وأشهد أنّني مولاك وعبدك»([955])، وبعد ذلك خرج الراهب من الدير، وأخذ يقدّم خدماته لسبايا آل البيت. ثمّ غادر أمراء القافلة الدير وأخذوا الرأس معهم. ولمّا قربوا من دمشق أرادوا تقسيم الأموال بينهم؛ خشيةً من يزيد أن يأخذها عند علمه بها، ففتحوا أكياس الأموال فإذا هي قد تحولّت خزفاً، وكتب على الوجه الأول للدينار: (وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)([956])، وعلى الوجه الآخر:(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)([957])، وعند ذاك رموها في نهر بردى، وتواصوا فيما بينهم بعدم الحديث عن ذلك([958]).
يذكر إبراهيم الزنجاني رواية دون الإشارة إلى مصادرها الأولية، جاء فيها أنّ قافلة سبايا آل البيت^ بعد مغادرتها دير الراهب، ساروا مجدّين فوصلوا إلى عسقلان، وأميرها «يعقوب العسقلاني([959])، وكان في حرب الحسين، فلمّا وصل العسكر مع الرأس والنساء إليه أمر أن يزيّنوا ذلك البلد، وأمر أصحاب اللهوّ أن يفرحوا ويلعبوا ويضربوا الطنبور والعود، وجلسوا في القصور مشغولين باللهوّ وشرب الخمر. فلمّا دخلوا وأدخلوا الرأس والنساء كان هناك رجل تاجر غريب اسمه زريد الخزاعي([960])وكان واقفاً، فسأل بعض النّاس عن سبب هذا الفرح والسرور، وعن سبب تزيين الأسواق فقالوا كأنّك غريب؟ قال: نعم، قالوا كان في العراق رجل مع جماعة وهم يخالفون يزيد ولم يبايعوه، فبعث إليهم عسكراً فقتلوهم وهذه رؤوسهم ونساؤهم. فسأل زريد يا هذا هؤلاء كانوا مسلمين أم كفرة؟ فقيل له: إنّهم سادات أهل الإسلام، فقال: ما كان سبب خروجهم على يزيد؟ قيل له: إنّ كبيرهم كان يقول: أنا ابن رسول الله وأنا بالخلافة أحقّ. سأل مَن كبيرهم؟ ومَن كان أبوه؟ ومَن كانت أمّه؟ قيل: أمّا اسمه: الحسين، وأخوه: الحسن، وأمّه: فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وأبوه: أمير المؤمنين. فلمّا سمع زريد ذلك اسودّت الدنيا في عينيه، وضاقت الأرض عليه، فجاء قريباً من السبايا، فنظر إلى علي بن الحسين وبكى بكاءاً شديداً، فقال زين العابدين: مالي أراك تبكي يا هذا وجميع أهل البلد في فرح وسرور؟! فقال: يا مولاي أنا رجل غريب قد وقعت في هذا البلد، وسألت أهل البلد عن سرورهم وفرحهم فقالوا: باغ بغي على يزيد فقتله وبعث برأسه ونسائه إلى الشام، فسألت عن اسمه، فقالوا هو الحسين بن علي وجدّه محمّد، فقلت: تباً لكم فمَن كان أحق منه بالخلافة؟! فقال×: جزاك الله يا زريد، فقد أرى فيك المعرفة ولنا المعرفة، قال: فقلت يا سيدي وهل لك حاجة؟ قال× قل لحامل الرأس أن يتقدّم على النساء؛ لتُشغَل النظّارة بالرأس عن النظر إلى النساء، قال: فمضيت من وقتي، وأعطيت حامل الرأس خمسين مثقالاً من الذهب والفضة حتى اعتزل وتقدّم به فاستراحت النساء من سدّ النظر»([961]).
ويُلاحَظ على هذه الرواية ـ التي يرويها أحد المحدّثين ـ أنّها لا تنسجم مع خط السير الجغرافي لقافلة السبايا بالمقارنة مع موقع مدينة عسقلان الذي يقع في فلسطين، والمعروف أنّ القافلة وصلت إلى شمال لبنان ثمّ اتجهت إلى دمشق، وقيل: إنّ والي عسقلان كان من المشاركين في جيش ابن زياد الذي حارب الإمام الحسين×، إلّا أنّنا لم نجد في المصادر التي اطّلعنا عليها ما يُشير إلى أنّ أحداً من أهل الشام كان مع جيش ابن زياد في الطفّ.
واصلت القافلة سيرها باتّجاه دمشق ومرّوا بمواضع منها سرغايا([962])، ومنها إلى الزبداني([963]).
وأشار أحد الباحثين المعاصرين، بأنّ قافلة السبايا قد مرّت بعدد من المواضع ما بين الزبداني ودمشق، وهي: التكية([964])، ومنها إلى عين الفِيجة([965])، ومنها إلى الهامة([966])، ومنها إلى دّمّر([967])، ومنها إلى الربوة([968]). وكانت القافلة تجدّ في سيرها حتى وصلت أحد أبواب دمشق في الأول من صفر سنة61هـ/680م([969])، ولم يُسمح لها بدخول دمشق، بل أُوقفت على ذلك الباب مدّة ثلاثة أيّام حتى أكملت السلطة الأموية استعداداتها للاحتفال بهذا الحدث([970]).
لقد جاءت قافلة سبايا آل البيت من غرب دمشق من جهة لبنان، أي: من طريق بعلبك، عين الفيجة، الهامة، دمشق، بمحاذاة نهر بردى. فإنّهم أول ما يصلون إلى دمشق القديمة المسوّرة فسيكون أمامهم الباب الصغير، أو باب الجابية([971])، حيث أنزلوهم عنده.
ولعلّ وصول القافلة من جهة الغرب إلى دمشق كان لإخفاء خبر وصول القافلة من قبل السلطة الأموية، مثلما أخفوا حقيقة سبايا آل البيت؛ كي لا يخرج النّاس لاستقبالهم قبل استكمال السلطة إجراءاتها الأمنية واستعداداتها الاحتفالية.
ونعتقد أنّهم أنزلوا سبايا آل البيت عند موضع يُدعَى اليوم مقبرة الباب الصغير([972]). ولا توجد رواية تذكر بأنّ أحداً من أهالي دمشق قد دَنَا من سبايا آل البيت وتكلّم معهم، على الرغم من بقائهم ثلاثة أيّام في هذا المكان.
ثمّ تمّ إنزالهم في المقبرة؛ لأنّ موقعها خارج غرب دمشق، وخالية من تواجد النّاس والعمران. وهذا المكان أصبحت فيه مقامات الإمام علي بن الحسين÷والسيّدات: زينب وأمّ كلثوم بنتا علي، وسكينة وفاطمة بنتا الإمام الحسين^، وبقية السبايا، وأشار لبيب بيضون بأن هذه المقامات هي التي باتوا فيها منذ نزولهم إلى أن أُذِن لهم بدخول دمشق، وليست مقابر لهم([973]).
وبهذا يكون سبايا آل البيت ـ إذا سلّمنا بأنّ خروجهم من الكوفة كان في ليلة الخامس عشر من المحرم ووصولهم إلى دمشق في الأول من صفرـ قد قضوا مدّة ستّة عشر يوماً إذا كان شهر المحرّم تسعة وعشرين يوماً في تلك السنة، أو سبعة عشر يوماً إذا كان شهر المحرّم ثلاثين يوماً في طريق سبيهم، عبر تلك المسافة الطويلة.
استعراض سبايا آل البيت ^ في دمشق
لقد بدأت مرحلة جديدة في حياة سبايا آل البيت^ عند وصولهم إلى أبواب دمشق ومن ثمّ دخولها، مرحلة ملؤها الآلام والمآسي والأحزان في هذه المدينة، لِما يضمره بنو أميّة من بغض وحقد لآل البيت، فكيف بهم وقد وقعت نساء الرسالة المحمّدية في أيديهم سبايا؟! فقد جاءت لهم الفرصة للتشفّي بهم والانتقام منهم.
قبل الحديث عن استعراض سبايا آل البيت في مدينة دمشق، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ يزيد بن معاوية عندما وصله خبر مقتل الإمام الحسين×زُعِمَ أنّه صدرت عنه بعض التصريحات التي تدلّ على حزنه وندمه لقتل الإمام الحسين×([974]).
ونعتقد أنّ هذه التصريحات لا تَعدو أكثر من كونها رواية أموية وُضِعت لتبرير الجريمة الكبرى التي اقترفها يزيد بن معاوية، وللتخلّص من جريمته بحقّ أهل البيت^وُضِعت تبعات هذا العمل على واليه في الكوفة عبيد الله بن زياد. ونعتقد أنّ حُزن يزيد أو بكاءه عند سماعه مقتل الإمام الحسين× ما هو إلّا تصنّع منه، لأنّه بعد قتل الإمام الحسين× حظي ابن زياد بالتكريم منه، فاستوسق كِلا العراقينِ الكوفة والبصرة لأبن زياد، كما أوصله يزيدُ بألف ألف درهمجائزة له لقتله الإمام الحسين×([975]). كما ورد أنّ يزيد بن معاوية جلس يوماً على شرابه وعن يمينه ابن زياد ـ وذلك بعد قتل الإمام الحسين× ـ فأقبَل على ساقيه فقال:
|
اسْقِني شَرْبَةً ترَوِّي
مُشاشي([976]) |
ثم أمر المغنّين فغنّوا بهذه الابيات([977]).
وأشار ابن أعثم إلى الحال التي أصبح عليها ابن زياد بعد قتله الإمام الحسين× وارتفاع شأنه في البصرة والكوفة، حيث اشترى دارين وهدمهما ثمّ بناهما وأنفق عليهما مالاً جزيلاً، وأسماهما الحمراء والبيضاء، فكان يشتّي في الحمراء، ويصيّف في البيضاء، وعلا أمره وارتفع قدره وانتشر ذكره، وبذل الأموال، واصطنع الرجال، ومدحته الشعراء([978]).
لقد كان ردّ يزيد بن معاوية على كتاب ابن زياد الذي أخبره فيه بأحداث الطفّ، أمراً بأن يبعث إليه رأس الإمام الحسين×ورؤوس مَن قتل معه([979])، وحمل ثقله وعياله إلى دمشق([980]).
ولما وصل محفز بن ثعلبة العائذي، والشمر بن ذي الجوشن باب قصر يزيد ومعهما رؤوس القتلى وسبايا آل البيت، رفع محفز ـ عند دخوله على يزيد ليقدّم له رأس الإمام الحسين× ـ صوته عالياً وقال: «جئنا برأس أحمق النّاس وألأَمهم»، فردّ يزيد عليه قائلاً: «ما ولدت أمّ محفز ألأَمَ وأحمق، ولكنه قاطع ظالم»([981]). وفي لفظ آخر لهذه الرواية وعند وصول محفز رفع صوته عالياً قائلاً: «أنا محفز بن ثعلبة، جئت برؤوس اللئام الكفرة، فقال يزيد: ما تحفّزت منه أمّ محفز ألأَم وأفجر»([982])، أو «ما ولدت أمّ محفز شرَّ وألأَم»([983]).
وروى سبط ابن الجوزي أنّ يزيد بينما كان جالساً في بهوٍ له مع أحد نُدمائه فقيل له: هذا زحر بن قيس الجعفي في الباب، فذعر واعتدل في جلسته وأذِنَ له بالدخول، وسأله عمّا وراءه، فأجابه ما تحب أبشر بفتح الله و نصره، وبدأ يُخبره بما جرى في الطفّ، وأنّ الحسين قدم إلى الطفّ بسبعين راكباً من أهل بيته وشيعته، وعرض عليه الأمان والنزول لحكم ابن زياد، فرفض ذلك واختار القتال، وبمدّة وجيزة أخذت السيوف ما أخذته من الرؤوس جميعاً، وتركت أجسادهم مجرّدة في الفلاة، فدمعت عين يزيد ولعن ابن مرجانة، وترحّم على أبي عبد الله الحسين، وأكّد على أن رضاءه هو بدون ما حصل من قتل الإمام الحسين×، وقبّح فعل ابن زياد هذا بقوله: قبّح الله ابن مرجانة، لو كان بينه وبين الحسين رَحِم ما فعل به هذا([984]). وعندما قدّموا الرؤوس له قال يزيد: «فرّقت سمية بيني وبين أبي عبد الله، وانقطع الرَحِم، لو كنت صاحبه لعفوت عنه، ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، رحمك الله يا حسين فقد قتلك رجل لم يعرف حقّ الأرحام»([985]). ثمّ يعطي يزيد العذر لابن زياد في قتله الإمام الحسين× لأنه اضطر إلى ذلك، ثمّ يُؤنّبه من جهة أخرى لقتله الإمام الحسين×؛ لأنّه بسبب ذلك جعل العداوة له في قلوب النّاس خيرهم وشرّهم. وقيل: إنّه تنكّر لابن زياد ولم يصل زحر بن قيس الجعفي بشيء([986]).
إنّ إهداء رأس الإمام الحسين×بين يدي يزيد بن معاوية ـ من قبل ابن زياد ـ ما هي إلّا بشرى لتأكيد النصر الذي حقّقه الأخير في قضائه على الإمام الحسين×، وعلى مَن خرج معه من أهل بيته وأنصاره الموالين لأهل البيت^([987]).
وفي رواية أخرى أشارت إلى أنّ الذي دخل على يزيد هما زحر بن قيس الجعفي والشمر بن ذي الجوشن، وأدخلا معهما رأس الإمام الحسين×، فرُمي بين يديه، ثمّ تكلّم الشمر قائلاً: «يا أمير المؤمنين، ورد علينا هذا ـ يعني الإمام الحسين ـ بثمانية عشر رجلاً من أهل بيته، وستين رجلاً من أصحابه ومن شيعته، فسُرنا إليهم، وسألناهم النزول على حكم أميرنا عبيد الله بن زياد أو القتال، فاختاروا القتال، فغدونا عليهم عند شروق الشمس، وأحطنا بهم من كلّ جانب، فلمّا أخذت السيوف مآخذها، جعلوا يلوذون لوذان الحمام من الصقور، فما كان إلّا مقدار جزر جزور أو نومة قائل، حتى أتينا على آخرهم، فهاتيك أجسادهم مجرّدة، وثيابهم مرمّلة، وخدودهم معفّرة، تسفي عليها الرياح، وزوارهم العقبان ووفودهم الرخم»([988]).
بينما أشار مؤرّخون آخرون، بأنّ الذي قال هذا الكلام ليزيد بن معاوية، هو زحر بن قيس الجعفي([989])، ولمّا سمع يزيد هذا الكلام قال: «قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، أمّا لو أنّي صاحبه لعفوت عنه»([990])، وقيل: إنّ يزيد دَمُعت عيناه([991])، ومن جانب آخر نجده قد قال: «كذلك عاقبة البغي والعقوق، ثمّ تمثّل يزيد:
|
مَن يذق الحرب يجد طعمها |
ويروى أنّ حامل رأس الإمام الحسين× ـ ومن دون ذكر اسمه ـ دخل على يزيد بن معاوية، ودَنَا منه وقال:
|
«أوقر ركابي فضةً وذهبا |
فقال له يزيد: إذا علمت أنّه خير النّاس لِم قتلته؟ قال: رجوت الجائزة، فأمر بضرب عنقه فحُزّ رأسه؟»([993]).
وأشار ابن عبد ربّه إلى «أنّه لمّا أُدخِل على يزيد بن معاوية سبايا آل البيت، ومن بينهم اثنا عشر شابّاً أكبرهم علي بن الحسين÷، وأيديهم مغلولة إلى أعناقهم، فقال يزيد لهم: أحرزت أنفسكم عبيد أهل العراق، وما علمت بخروج أبي عبد الله ولا بقتله»([994]).
ولمّا وصل صاحب البريد إلى يزيد، وهو مريض معصّب الرأس ويداه ورجلاه في طشت من ماء حارّ وبين يديه الطبيب يعالجه، وعنده جماعة من بني أميّة يحادثونه قال له: «أقرّ الله عينيك بورود رأس الحسين، فنظره شزراً وقال: لا أقرّ الله عينيك، ثمّ قال للطبيب: أسرع واعمل ما تريد أن تعمل، وخرج الطبيب عنه وقد أصلح جميع ما أراد أن يصلحه، ثمّ أخذ كتاباً بعثه إليه ابن زياد وقرأه، فلمّا انتهى إلى آخره عضّ على أنامله حتى كاد أن يقطعها، ثمّ قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ودفعه إلى مَن كان حاضراً، فلمّا قرأوه قال بعضهم لبعض: هذا ما كسبت أيديكم، فما كان إلّا ساعة وإذا بالرايات قد أقبلت، ومن تحتها التهليل والتكبير»([995]).
وفي رواية أخرى أتي برأس الإمام الحسين× إلى يزيد بن معاوية فقال: «عليَّ بالنعمان بن بشير، فلمّا جاء قال: كيف رأيتَ ما فعل عبيد الله بن زياد؟ قال النعمان: الحرب دول. فقال يزيد: الحمد لله الذي قتله، قال النعمان: قد كان أمير المؤمنين معاوية كره قتله، قال يزيد: ذلك قبل أن يخرج، لو خرج على أمير المؤمنين والله قتله إن قدر، قال النعمان: ما كنت أدري ما كان يصنع، ثمّ خرج النعمان، قال يزيد: هو كما ترون إلينا منقطع، قد ولّاه أمير المؤمنين ورفعه، لكن أبي كان يقول: لم أعرف أنصارياً قطّ إلّا يحب علياً وأهله، ويبغض قريشا بأسرها»([996]).
ممّا تقدّم يمكن القول أنّ يزيد بن معاوية، تارةً تراه يتظاهر بأنّه لا يدري بخروج الإمام الحسين بن علي÷، وأنّه لم يأمر بقتله ولا راضٍ بقتله، ولو رجع الأمر إليه لعفى عنه، ويكفيه طاعة أهل العراق بدون قتلهم للحسين×، وقد ذرفت عيناه بالدموع عندما قدّم له رأس الإمام الحسين×؛ ليبرهن أمام مَن كان عنده على عدم رضائه بقتل الإمام الحسين× وتأسفه على ذلك. وتارةً تراه يحمد الله تعالى على قتل الإمام الحسين×، ويؤكّد على أنّه لو كان قد خرج على أبيه معاوية لقتله أيضا. ثمّ إنّ يزيد أمر بقتل الأمير الذي قدّم له رأس الإمام الحسين×؛ بسبب مدحه أبوَي الإمام الحسين×. وعندما وضع رأس الإمام الحسين× أمامه في طبق من ذهب سأل الرأس بقوله: كيف رأيتَ يا حسين؟! ([997]). ورُوي عن زيد بن علي وعن محمّد بن الحنفية، عن الإمام علي بن الحسين÷، قال: «لمّا أُوتي برأس الحسين إلى يزيد كان يتّخذ مجالس الشرب، ويأتي برأس الحسين فيضعه بين يديه ويشرب عليه»([998]).
والحقيقة أنّ مقتل الإمام الحسين× لم يكن بالأمر المفاجئ وبدون تخطيط، ولم يكن من دون علم يزيد بن معاوية، بل كان بأمره، وقد شدّد على تحقيق ذلك منذ أن كان الإمام الحسين× في المدينة المنوّرة، ولم يذرف دموع عينه عندما قُدّم أمامه رأس الإمام الحسين× في مجلس خاصّ ضمّه مع بني أميّة، ولم يُظهر عدم رضائه على ذلك. أمّا تحميله ابن زياد كامل المسؤولية في قتله للحسين؛ إنّما ذلك لامتصاص نقمة الخاصّة والعامّة من النّاس، وإثبات براءته، وعدم أمره لفعل ذلك أو الرضا به، وبالتالي أراد التنصّل عن مسؤولية قتل الإمام الحسين×([999]).
ولو لم يكن الأمر هكذا فلماذا لم يتّخذ أيّ إجراء ضد ابن زياد والي الكوفة، إذ كان قتل الإمام الحسين× بقرار اتّخذه من نفسه، ودون أمر أو علم سيّده يزيد، بل بالعكس قام بتكريم ابن زياد، واستعرض سبايا آل البيت في شوارع دمشق وأسواقها عند وصولهم لها، وشربه الخمر عند رأس الإمام الحسين×، فضلاً عن إنشاده الشعر الذي عبّر فيه عن فرحه وسروره بأخذه ثأر بني أميّة، وأمره بصلب رأس الحسين على أبواب دمشق ثلاثة ايام([1000])، وصلب الرأس الشريف في المدينة المنوّرة عند إرساله إليها على خشبة، ثمّ رُدّ إلى دمشق([1001]).
إضافة إلى محاولاته في إذلال السبايا، فقد أشارت الروايات التاريخية التي وصفت دخول سبايا آل البيت إلى دمشق أنّهم أمضوا ثلاثة أيّام عند أحد أبواب سورها، منذ وصولهم إلى دمشق([1002]) في الأول من صفر سنة61هـ/680م([1003])؛ لاستكمال استعدادات الاحتفال بهذا اليوم([1004]) الذي كان يزيد بن معاوية ينتظره، وقد أعدّ له عدّته، وهيّأ له من الاستعدادات ما يتناسب مع هذا الحدث، وجعله يوماً خاصّاً من أيّام فرحه وزهوه وانتصاره([1005]) وعيداً لبني أميّة([1006])، بينما عدّ المسلمون العام الذي قتل فيه الإمام الحسين بن علي÷ عام حزن([1007]).
ومن الإجراءات التي أمر بها يزيد بن معاوية احتفالاً بهذا اليوم، تزيين المدينة بالحلي والحلل والحرير والديباج([1008])، وإحضار مائة وعشرين راية([1009]) يستقبل بها رأس الإمام الحسين×وتدخل معه إلى المدينة([1010]). وخرج الرجال والنساء، الأصاغر والأكابر للتفرّج على سبايا آل البيت ومعهم الطبول والدفوف والأبواق والمزامير، وسائر آلات اللهو والطرب([1011])، ولم ير الراؤون أشدّ احتفالاً ولا أكثر اجتماعاً منه([1012]). وكلّ هذا يبغي يزيد بن معاوية من ورائه استعراض سبايا آل البيت في موكب يوحي للعامّة والخاصّة بانتصاره على خصومه، من خلال التفرّج على نسائهم وما بقي من رجالهم.
لقد أقام سبايا آل البيت ثلاثة أيّام عند وصولهم مدينة دمشق في أحد أبواب سورها الخارجي، وهي ستّة أبواب: باب الجابية([1013])، الباب الصغير([1014])، باب كيسان([1015])، الباب الشرقي([1016])، باب توما، باب الفراديس([1017]).
وعند شروق شمس اليوم الرابع ساروا بهم حول مدينة دمشق القديمة بمحاذاة السور مروراً بأبوابها، ثمّ أدخلوهم إلى داخل المدينة([1018]) من باب توما، وعبروا بهم من الباب الداخلي؛ إذ إنّ الطريق من باب توما إلى باب جيرون الداخلي يؤدّي بالقادم من جهة الشرق إلى مكان قصر المُلك ـ أي قصر الخضراء([1019]) الذي بناه معاوية بن أبي سفيان أيّام إمارته على الشام، التي بدأت في سنة 17هـ/638م([1020])، ثمّ صار قصراً ليزيد بن معاوية (60ـ64هـ/679ـ683م) عند توليه الحكم ـ وذلك للمرور بالساحة العامّة الواسعة التي تُقام فيها المهرجانات والاحتفالات، وهي قريبة من قصر يزيد والمسجد الجامع([1021])، وقد تجمعت فيها أعداد كبيرة من النّاس المتفرجين، وأعداد من العسكريين الذين فُرِض عليهم التواجد([1022]).
لقد بدأ استعراض سبايا آل البيت في شوارع دمشق وأسواقها منذ الصباح الباكر، يحيط بهم رجال الجيش متّجهين بهم إلى قصر يزيد، ولكن لم يصلوا إليه إلّا بعد الظهر؛ وذلك للازدحام الشديد لكثرة أعداد النّاس المتفرّجين من جهة([1023])، وإيقافهم في بعض أبواب المدينة من جهة أخرى ، ففي باب الساعات وقفوا ثلاث ساعات؛ ينتظرون الإذن من يزيد بالدخول ([1024])، ممّا جعل حركة السير بطيئة. ومعهم أقبلت الرايات ومن تحتها التكبير والتهليل([1025])، وقد خرج يزيد بنفسه ليتلقّاهم([1026])، وكما مرّ معهم الأطفال والغلمان والنساء من ذرية أبي طالب بن عبد المطّلب([1027]). ولمّا أشرف سبايا آل البيت^ على ثنية العقاب([1028])، ورآهم يزيد وهو على منظرة([1029]) في ربى جيرون([1030]) أنشد:
|
لمّا بدت تلك الحمولُ وأشرقت |
كان التفرّج على نساء آل البيت^من قبل النّاس يؤذيهنَّ كثيراً؛ لأنّه يعتبر هتكاً لحرمتهنّ، وغير مناسب لنساء بيت النبوة، ممّا جعل السيّدة زينب بنت علي÷([1032]) ـ وقيل: سكينة بنت الإمام الحسين× ـ لمّا أوشكت قافلة السبايا دخول دمشق، تقترب من الشمر بن ذي الجوشن وتطلب منه أن يأخذ بهم ـ عند دخول المدينة ـ طريقا غير مأهول حتى لا يكونوا في معرض الفرجة، ومن ثمّ إخراج رؤوس القتلى المتفرّقة بين القافلة إلى أمامها؛ لينشغل النّاس بالنظر إليها دون النظر إليهنّ، إلّا أنّ الشمر لم يستجب لذلك، وفعل عكس ما طُلِب منه، وجعل رؤوس القتلى على الرماح مرفوعة في وسط القافلة، وسار بهم في طريق مزدحم بالنّاس المتفرّجين، إلى أن وصل بهم إلى درج باب المسجد الجامع، وأوقفوا عنده السبايا، تمهيدا لإدخالهم على حاضرة الحكم الأموي([1033]).
لقد وصف الصحابي سهل بن سعد الساعدي([1034]) الزائر لدمشق ـ والذي كان موجوداً يوم استعراض سبايا آل البيت ـ الاحتفال الكبير بذلك، وقد نقل وصفه أبو مخنف (ت157هـ/773م) بقوله: «قال سهل: ودخل النّاس من باب الخيزران([1035])، فدخلتُ في جملتهم، وإذ قد أقبل ثمانية عشر رأساً، وإذا السبايا على المطايا بغير غطاء، ورأس الحسين في يد الشمر ـ لعنه الله ـ وهو يقول: أنا صاحب الرمح الطويل، أنا قاتل ذي الدين الأصيل، أنا قتلت ابن سيّد الوصيّين، وأتيتُ برأسه إلى أمير المؤمنين([1036])، فقالت زينب: كذبت يا لعين ابن اللعين، ألا لعنةُ الله على القوم الظالمين، يا ويلك تفتخر بقتل مَن ناغاه في المهد جبرائيل وميكائيل، ومَن اسمه مكتوب على سرادق عرش ربّ العالمين، ومَن ختم الله بجدّه المرسلين، وقمع بأبيه المشركين، فمن أين مثل جدّي محمّد المصطفى، وأبي علي المرتضى، وأمّي فاطمة الزهراء؟! فأقبل عليها خولي وقال: تأبين الشجاعة، وأنت بنت الشجاع.
قال (سهل): أقبل من بعده رأس الحرّ بن يزيد الرياحي، وأقبل من بعده رأس العباس يحمله قشعم الجعفي([1037])، وأقبل من بعده رأس عون يحمله سنان بن أنس، وأقبلت الرؤوس على أثرهم»([1038]).
ويُلاحظ على هذه الرواية إقرار الشمر مع افتخاره بقتله للحسين بأنّه ذو الدين الأصيل، وأنّ أباه هو سيّد الوصيين، ويقصد به علي بن أبي طالب×، وسيُقدّم رأسه إلى أميره يزيد بن معاوية؛ للتقرّب منه ونيل جائزته. وأنسى الشمرَ حبُّ الدنيا عمّا سيُلاقيه في الدنيا والآخرة معاً. ولم تتركه السيّدة زينب بنت علي÷ وحاله، بل ردّت عليه مبينةً له سوء فعله بقتله الإمام الحسين×؛ لمكانته عند الله تعالى، وإنّ جده’ آخر المرسلين، وأباه× مَن صال وجال في حروبه مع المشركين لتثبيت أركان الإسلام، فأيّ فخر هذا الذي يفتخر به الشمر؟! وكل ذلك على مسمع المتفرجين. ومن ردّها هذا على الشمر، بيّنت كذب الدعاية الأموية القائلة بأنّهم من الخوارج، بل إنهم آل بيت النبي.
كما توهّمت الرواية بذكرها رأس الحر بن يزيد الرياحي بأنّه كان مع رؤوس القتلى التي وصلت إلى دمشق، والحقيقة أنّ الحرّ لم يُقطع رأسه يوم الطفّ؛ لأنّ عشيرته لم توافق على ذلك وأخذت جسده كاملاً ودفنته([1039]).
ثمّ إنّ ما يُؤاخذ على على هذه الرواية، هل أنّ سهلاً شاهد ثلاثة رؤوس فقط مع رأس الإمام الحسين× فصرح بأسماء أصحاب تلك الرؤوس مع أنه ذكر عدد الرؤوس بثمانية عشر؟ فأين معرفته بأسماء بقية أخوة الإمام الحسين× وأبنائه؟! إذ لابد من معرفته بهم والتصريح بأسمائهم، فهو من الصحابة الذين عاشوا في المدينة، وربما التقى ببعضهم.
وقد رُوى عن الشعبي([1040])وصفه لجانب من استعراض سبايا آل البيت في دمشق، إذ قال: «أشرفت تسع عشرة راية حمراء، وأشرفت السبايا مهتكات بلا وطاء، ثمّ أقبل رأس العباس بن علي يحمله ثعلبة بن مرة الكلبي([1041]) وبيده رمح طويل، وهو ينشد ويقول:
|
أنا صاحبُ الرمحِ الطويلِ الذي
به |
وقد ردّت عليه زينب: ويلك أتفتخر بقتلك آل بيت محمد؟! فعليك لعنة الله، وهمّ أن يضربها بسوطه، وخشي على نفسه الخجل من النّاس. ثمّ أقبل من بعده رأس جعفر بن علي يحمله نمير بن أبي جوشن الضبابي([1042])، وأقبل من بعده رأس محمّد بن علي، ثمّ أقبل رأس أبي بكر بن علي يحمله أنيس بن الحرث البعجي([1043])، وأقبل من بعده رأس علي بن الحسين يحمله مرّة بن قيس الهمداني([1044])، وأقبل من بعده رأس عون بن علي يحمله جابر السعدي([1045])، وأقبل من بعده رأس القاسم بن الحسن يحمله محمّد بن الأشعث الكندي([1046])، وأقبل من بعده رأس يحيى بن علي يحمله عمير بن شجاع الكندي([1047])، وأقبل من بعده رأس عبد الله ابن عقيل يحمله قيس بن أبي مرّة الخزاعي([1048])، ثمّ أقبلت من بعده بقية الرؤوس، ثمّ أقبل رأس الإمام الحسين×، وهو أشبه الخلق برسول الله’، يحمله حواش بن خولّي بن يزيد الأصبحي([1049])، وقيل غيره»([1050]).
ويسترسل أبو مخنف في روايته ويقول: «أقبلت جارية على بعير مهزول بغير غطاء ولا وطاء، على وجهها برقع خزّ أدكن، وتنادي: وامحمداه واجداه، واعلياه واأبتاه، واحسناه واحسيناه، واعقيلاه، واعباساه، وابُعد سفراه، واسوء صباحاه، فلمّا أقبل سهل إليها صاحت به فوقع مغشيّاً عليه، فلمّا أفاق دَنَا منها، وقال لها: سيدتي لِم تصيحين عليَّ؟ قالت: أما تستحي من الله ورسوله أن تنظر إلى حُرم رسول الله؟! فقال لها: والله ما نظرت إليكم بريبة، فقالت مَن أنت؟ فقال لها: أنا سهل بن سعيد الشهر زوري([1051])، وأنا من مواليكم ومحبّيكم»([1052]).
لقد أدّينَ بنات الرسالة المحمدية دوراً إعلامياً مهماًّ؛ لفضح بني أميّة، ورداً على ممارساتهم الإعلامية الكاذبة في طمس الحقيقة، وتغيير ما علق في أذهان البعض من أنّ هؤلاء النسوة كان رجالهنّ من الخوارج فاستحقّوا القتل وسُبي نساؤهم. ومثلما كان لهذه النسوة دور في الكوفة في فضح بني أميّة، كذلك كان لهنَّ دورا بارزا عند استعراض سبايا آل البيت^ في شوارع دمشق المزدحمة بالنّاس المتفرّجين، حيث انبرت إحداهنّ ـ ونظنّ أنّها السيّدة سكينة بنت الإمام الحسين‘ ـ ونادت بصوت عالٍ بأنّ هذا الذي يجري عليهم لا يليق بهم ولا يستحقونه من بعد المسافة التي قطعوها في سبيهم، واستعراضهم في هذه الشوارع منذ ساعات الصباح الباكر، وأنّ الذين ندبتهم في ندائها هم أجدادها (النبي محمّد’، والإمام علي×، وعقيل بن أبي طالب)، وأعمامها (الإمام الحسن والعباس^)، وأبوها الإمام الحسين×، ومع كلّ هذا أيستحق بيت أجدادها، وهم بيت النبوة، وفيه سيّدا شباب أهل الجنّة، كلّ هذا الذي جرى عليهم؟!
ثمّ إنّ هناك مبالغة في أنّ سهلاً قد أصيب بحالة الإغماء، لصياح سكينة عليه عندما تقدّم نحوها ليكلّمَها، إذ هل كان صوت سكينة من القوة والعلو في ظل ضوضاء النّاس المتفرّجين مؤثّراً ومؤذياً على مَن يسمعه لدرجة يقع معها على الأرض، ويُصاب بالإغماء؟!
كما نقل الخوارزمي(ت568هـ/1172م) وصف سهل بن سعد الساعدي لاستعراض سبايا آل البيت في دمشق بقوله: «خرجتُ إلى بيت المقدس حتى توسّطت الشام، فإذا أنا بمدينة مضطردة الأنهار، كثيرة الأشجار، قد علقوا الستور والحجب والديباج، وهم فرحون مستبشرون، وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول، فقلت في نفسي: لعل لأهل الشام عيداً لا نعرفه نحن! فرأيت قوماً يتحدّثون، فقلت: يا هؤلاء ألكم في الشام عيد لا نعرفه نحن؟! قالوا: يا شيخ نراك غريباً، فقلت أنا سهل بن سعد، قد رأيت رسول الله وحملت حديثه، فقالوا: يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر دماً، والأرض لا تخسف بأهلها، قلتُ: ولِم ذاك؟ فقالوا: هذا رأس الحسين، عترة رسول الله، يُهدى من أرض العراق إلى الشام، وسيأتي الآن. قلتُ: واعجباه؟ يُهدى رأس الحسين والنّاس يفرحون! فمن أيّ باب يدخل؟ فأشاروا إلى باب يقال له: باب الساعات([1053])، فسرتُ نحو الباب، فبينما أنا هناك إذ جاءت الرايات يتلو بعضها بعضاً، وإذا أنا بفارس في يده رمح منزوع السنان، وعنده رأس من أشبه النّاس برسول الله وجهاً، وإذ بنسوة من ورائه، على جِمال بغير غطاء، فدنوت من إحداهن فقلت لها: يا جارية من انت؟ فقالت: أنا سكينة بنت الحسين، فقلتُ لها: ألكِ حاجة إليّ؟ فانا سهل بن سعد ممّن رأى جدك وسمعت حديثه، قالت: يا سهل قل لصاحب الرأس أن يتقدّم بالرأس أمامنا، حتى يشتغل النّاس بالنظر إليه فلا ينظرون إلينا، فنحن حُرم رسول الله. قال: فدنوتُ من صاحب الرأس وقلت له: هل لكَ أن تقضي حاجتي وتأخذ منّي أربعمائة دينار؟ قال: وما هي؟ قلتُ: تُقدِّم الرأسَ أمام الحرم، ففعل ذلك، ودفعت له ما وعدته، ثمّ وضع الرأس في حقة([1054]) (سلّة)، وأُدخِلوا على يزيد، فدخلت معهم، كان يزيد جالساً على سرير وعلى رأسه تاج مكلّل بالدرّ والياقوت، وحوله كثير من مشايخ قريش، فدخل صاحب الرأس ودَنا منه... »([1055]).
يتبيّن من رواية الخوارزمي أنّها أكثر تفصيلاً وتوضيحاً من رواية أبي مخنف، في الكيفية التي استعرضوا فيها سبايا آل البيت عند وصولهم إلى دمشق، من دخول الرايّات متتالية بعضها تلو البعض الآخر؛ لكثرة عددها، ثمّ دخول رأس الإمام الحسين× مرفوعاً على رمح طويل منزوع السنان، ونساء آل البيت خلفه إلى أن أوصلوهم إلى درج باب الجامع الأموي، وبعدها أدخلوهم على يزيد بن معاوية في قصره.
ثمّ تذكر هذه الرواية أنّ سكينة بنت الإمام الحسين÷ طلبت من سهل وليس من الشمر، وهذا أقرب إلى الواقع؛ إذ لا يمكن أن تطلب سكينة من الأعداء الذين قتلوهم وسبوهم، بل طلبت من سهل ـ بعد أن عرَّف بنفسه من أنّه صحابي ـ بأن يبعد رؤوس القتلى وهي مرفوعة على الرماح من وسط القافلة؛ كي لا يُنظر سويةً إلى الرؤوس والنساء، بل سيكون النظر إلى الرؤوس دون النساء فيما لو أبعدت عن وسط القافلة إلى الإمام.
ولكن من غير الممكن أن يتمّ إنزال الرؤوس تلبية لطلب سهل بن سعد لدفعه الأموال ووضعها في سلة؛ إذ لا يتماشى هذا مع الغرض من الاستعراض الكبير الذي انشغل يزيد بن معاوية بالإعداد له، ولمدّة ثلاثة أيّام، ومنذ وصول قافلة سبايا آل البيت إلى سور دمشق.
ثمّ إنّ سهل بن سعد الساعدي توجّه إلى الإمام علي بن الحسين÷وفقاً لرواية أبي مخنف، وقال له: «مولاي هل لكَ حاجة؟ فقال علي بن الحسين لي: هل عندك شيء من الدراهم؟ فقلتُ: ألف دينار وألف ورقة، أي دراهم([1056])، فقال علي: خُذ منها شيئاً وادفعه إلى حامل الرأس، وأمره بأن يبعده عن النساء؛ حتى تنشغل النّاس بالنظر إليه عن النساء، قال سهل: ففعلتُ ذلك ورجعتُ إليه، وقلتُ: يا مولاي فعلتُ ذلك الذي أمرتني به، فقال لي: حشرك الله معنا يوم القيامة»([1057]).
يُلاحظ من هذه الرواية أنّ أشدّ ما يؤذي أهل البيت× هو النظر إلى نسائهم من قِبَل النّاس المتفرّجين، لذا لم يقتصر طلب إبعاد الرأس من وسط القافلة على نساء أهل البيت^، بل كان هذا الأمر يشغل بال الإمام علي بن الحسين÷ أيضا، ويعدّه أمراً ثقيلاً رغم مرضه الشديد والغلّ في يديه إلى عنقه وما تعرّض إليه من تعب السبي، إلّا أنّه طلب من سهل بن سعد عند سلامه عليه أن يعطي لصاحب الرأس مبلغاً من المال؛ ليخرجه من بين النساء السبايا إلى الإمام لينشغل النّاس بالنظر إليه دون النساء، وقد فعل هذا سهل، ودعا له الإمام علي بن الحسين÷بأن يحشره الله تعالى مع أهل البيت^يوم القيامة.
ثمّ إنّ الرواية يُفهم منها أنّ هناك رأساً واحداً لا عدداً من الرؤوس، وكذلك لم يذكر اسم صاحب الرأس هذا، ولكن هل تمّ إبعاد الرأس؟ وهل أُبعد عند طلب سكينة من سهل بن سعد، أو عند طلب الإمام علي بن الحسين÷ من سهل ذلك؟ ومع ذلك نعتقد أنّ الرأس الشريف لم يُبعد عن وسط قافلة السبايا؛ لأنّه يخالف ما تمّ وضعه من منهاج للاستعراض، وأنّ أيّ خلل في ذلك سيكون منظوراً أمام القائمين على الاستعراض، وبالتالي مَن يجرأ على أن يأخذ الأموال ويُقدّم الرأس إلى الإمام، أو يضعه في سلّة ويخفيه عن رؤية النّاس؟!
وينقل الباحث لبيب بيضون قولاً عن سهل بن سعد، دون الإشارة إلى المصدر الذي أخذ منه تلك الرواية، حيث يصف سعد شاكياً متألماً مخاطباً رسول الله لمّا رأى رأس الإمام الحسين×على الرمح، بقوله: «يا رسول الله، ليت عينيك ترى رأس الحسين في دمشق، يُطاف به في الأسواق... »([1058])، وهذه مواجع يشعر بها كلّ ذي لُبّ، يرى سبايا آل البيت بهذه الحالة المأساوية.
ويبدو أنّ ظاهرة الفرح والسرور التي عمّت بلاد الشام يومذاك، ناشئة من الجهل المطبق عند عامّة النّاس عن حقيقة السبايا الذين تمّ سبيهم، وأنّ هناك قسماً آخر كان يعلم ذلك لأنه أموي الهوى.
وقد برزت مواقف أظهرت ـ في ما لا يقبل الشكّ ـ أنّ كثيراً من أهل الشام أثرّت سياسة التضليل الأموي على آرائهم ومواقفهم، ممّا جعل بعضهم يتّخذ موقفاً سلبياً من سبايا آل البيت، ولكن ما إن تتجلّى صورة الحقيقة أمامه حتى يتراجع عن موقفه، ويتحوّل ذلك السلب إلى الإيجاب، وينقلب على بني أميّة، وربما يدفع حياته ثمناً لذلك، ففي شدّة الازدحام وقف شيخ كبير السن، بعد أن دَنَا من سبايا آل البيت^، وانهال عليهم بقوله: «الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم، وأراح الرجال من سطوتكم، وأمكن أمير المؤمنين منكم. فقال علي بن الحسين له: يا شيخ هل قرأتَ القرآن؟ قال: نعم قرأتُه، قال علي: هل قرأتَ هذه الآية: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)([1059])؛ قال الشيخ: قد قرأتُ ذلك، قال علي بن الحسين: فنحن القربى يا شيخ، قال علي: هل قرأتَ في القرآن: (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)([1060])؟ قال الشيخ: قد قرأتُ، فقال علي بن الحسين÷: فنحن القربى يا شيخ، فهل قرأتَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([1061])؟ قال الشيخ: قد قرأتُ ذلك، فقال علي بن الحسين: نحن أهل البيت الذي خصّصنا بآية التطهير، فبقي الشيخ ساكناً، نادماً على ما تكلّم به، ثمّ رفع رأسه إلى السماء، وقال: اللهمّ إنّي تائب إليك ممّا تكلمته، وأبرأ إليك من عدوّ محمّد وآل محمّد من الجنّ والإنس»([1062]).
وهذا أول حديث للإمام علي بن الحسين÷ تحدّث به في دمشق، إذ إنّه لم يتكلّم مع أحد طوال سيره في طريق السبي من الكوفة إلى بلاد الشام([1063])؛ لأنّه كان ينتظر الفرصة المناسبة ليتحدّث مع النّاس لتستقبل نصائحه كاشفاً الحقيقة لهم، فما إن وجد ذلك الشيخ الشامي الذي انبرى بكلامه موبّخاً لسبايا آل البيت، وحامداً الله تعالى على قتل رجالهم وسبي عيالهم لان عقله مليء بذلك وأمثاله. وكذلك كثير من الآخرين بما بثّته ماكنة الإعلام من الفكر الأموي ـ اذا جاز أن يُسمّى فكراً أموياً ـ وقد وجد الإمام علي بن الحسين÷فيه الاستعداد ليسمعه، خاصّة وأنّ الإمام علي بن الحسين÷ بدأ حديثه معه في تذكيره بآيات من القرآن الكريم، وفيمَن نزلت، والتي سرعان ما سيطرت على روح الشيخ وعقله، وكشفت له الحقيقة. وبالرغم من أنّ هذا الشيخ لم ير رسول الله’ ولا عليّاً×ولا أولاده، لكنّه على ما يبدو كان يمتلك فطرة سليمة، وعقلاً راجحاً، ممّا عدّ أول رفض صدر منه ضد فعل بني أميّة، على عكس مَن قتل الإمام الحسين× ورجال بيته وأنصاره، وسبوا عياله، وكان كثير منهم قد رأى علياً والحسن والحسين^. ثمّ إنّ الشيخ لم يتوانَ ولم يتردد عن تبرئه من يزيد وسلطته، ويستغفر الله تعالى ويسأله التوبة، مع علمه بالنتائج التي تترتّب على موقفه هذا، إذ ما إن سمع يزيد بخبره حتى أمر بقتله([1064])؛ ليكون عبرة في الوسط الشامي، وبالتالي إخافة هذا الوسط وابقائه في جهله.
لقد انفرد عماد الدين الطبري في رواية مفادها: إنّ سبايا آل البيت^ عندما أُوقِفوا على درج باب المسجد بقوا على هذه الحالة ستّة وستّين يوماً، لا يستطيع أحد من النّاس أن يسلّم عليهم أو يكلّمهم، إلى أن تقدّم الشيخ الشامي إلى الإمام علي ابن الحسين÷ وكلّمه([1065])، وقد أشرنا إلى ذلك آنفاً.
وهذه الرواية لا يمكن القبول بها؛ لأنّها لم تُذكر من قبل المؤرِّخين الذين سبقوا عماد الدين الطبري، ثمّ إنّه أشار إلى أنّ مكان وقوع الحادثة كان على درج باب المسجد، وحقيقة الأمر أنّها وقعت أثناء سير السبايا في الازدحام الشديد. كما لا يمكن قبول قول القائل بأنّ السبايا بقوا مدّة ستّة وستّين يوماً في دمشق، ونعتقد أنّ كلمة ستّين قد أُضِيفت إلى كلمة ستّة وذلك بسبب التصحيف، أو من وضع الوضّاعين لتشويه الحقيقة، وبالتالي فلا يمكن قبولها.
وخلاصة القول: إنّ خشية ابن زياد من تطوّر الأحداث في الكوفة إلى ما لا تُحمد عقباه، وهو يروم إرسال سبايا آل البيت^ إلى بلاد الشام، جعلته يصحب قافلة السبايا بجيش يقوده عدد من أمرائه البارزين، أمثال محفز بن ثعلبة العائذي، والشمر بن ذي الجوشن، وزحر بن قيس الجعفي، وخولي بن يزيد الأصبحي، وشبث بن ربعي، وعمرو بن الحجّاج، وبعض مساعديهم، من أمثال: أبو بردة بن عوف الأزدي، وطارق بن أبي ظبيان الأزدي. وأُدخِل رأس الإمام الحسين× على يزيد بن معاوية في الأول من صفر سنة 61هـ/680م أولاً، سواء كان الرأس الشريف قد أُرسِل وحده إلى دمشق، أم كان بصحبة بقية الرؤوس والسبايا.
وقد مرّ سبايا آل البيت^ برحلة قاسية ومريرة، من الكوفة إلى بلاد الشام عبر طريق طويل مرّ ببعض البوادي والمرتفعات، يتفرّج عليهم سكّان المدن والقُرى، وكان لسكّانها مواقف متباينة، فمنهم مَن هم ذوي هوى أموي، عارفاً بحقيقة ما يجري مِن قتل الإمام الحسين× وأهل بيته وأنصاره، وسبي عياله، فقد استقبل القافلة فرحاً مستبشراً راقصاً مغنّياً، وقدّم إلى مَن كان بصحبة القافلة من الأمراء الأمويين وأفراد جيشهم المساعدات من الطعام والشراب والمبيت، وإن إختلفتْ من موضع إلى آخر، أمثال تكريت، نصيبين، دعوات، معرّة النعمان، الرستن، وبعلبك. ويُعدّ هذا تجاوزاً للدين والأخلاق الاجتماعية والإنسانية، لأنّهم عاشوا التضليل الأموي ضد آل البيت مدّة ليست بالقصيرة، بعد أن تولّى معاوية بن أبي سفيان الإمارة في دمشق سنة 17هـ/638م، والذي نهج سياسة عدائية ضد الإمام علي بن أبي طالب×([1066]).
ومن سكّان هذه المدن والقُرى مَن كان على عكس أولئك، حيث كان يعرف الحقيقة ومرارتها، أو عرفها من خلال اطّلاعه عند مرور قافلة سبايا آل البيت^، فكان موقفهم الشجب والاستنكار، ولم يظهر منهم أي تأييد للأمويين على فعلهم المشين هذا، الذي وصل إلى حدّ التجاوز على أمراء بني أميّة وأعوانهم، ولم يقدّموا لهم شيئاً، بل قاتلوهم ولم يسمحوا لهم بدخول مدنهم أو قراهم، وهذا ما حصل في الموصل، ولينا، وحلب، وقنسرين، وشيزر، وكفر طاب، وسيبور، وحماة وحمص. ومردّ هذه المواقف هو الثبات على مبادئ الإسلام.
أمّا مواقف النّاس من غير المسلمين فقد كان واضحاً بالرفض والاستنكار لأفعال بني أميّة في قتلهم للإمام الحسين× وأهله وأنصاره وسبي عياله، فكان موقف نصارى تكريت واضحاً، فما أن عرفوا بأنّ الرأس هو رأس الإمام الحسين×حتى منعوا أمراء الجيش وأفراده من دخول المدينة، وأعلنوا حالة الحداد بضرب النواقيس، وكذلك موقف صاحب الصومعة في بلاد الشام بعد أن أخذ الرأس الشريف بات يبكي عليه، وقبل أن يرجعه إلى أمراء القافلة تشهّد بالشهادتين وأشهر إسلامه، وجرى الفعل نفسه من قبل اليهودي في قنسرين، حيث أخذ الرأس ونظّفه وعطّره، ونطق الرأس الشريف عنده، فكان ذلك سبباً لإسلامه.
ولم يتّعظ بعض أهالي المدن والقرى بالكرامات التي حصلت للإمام الحسين×، كنقطة الدم من الرأس الشريف في الموصل، وعدم دخول الفارس الذي كان يحمل رأس الإمام الحسين× إلى مدينة نصيبين، وكذا نقطة الدم التي سالت من الرأس على سفح جبل الجوشن في حلب، والتي بُني عليها مشهد، فضلاً عن بناء مشهد السقط أو الدّكة، الموضع الذي أسقطت فيه إحدى زوجات الإمام الحسين×حملها على السفح ذاته.
ثمّ بدأت مرحلة جديدة لسبايا آل البيت^ أكثر قسوة ومعاناة، وذلك عند وصولهم مدينة دمشق، ودخولها بعد الدوران حول سورها، واستعراضهم في شوارعها وأسواقها، وحشود النّاس المتفرّجين عليهم، الذين يبدون فرحهم وسرورهم أيضا، ثمّ دخولهم إلى مجلس يزيد بن معاوية في قصره، والذي ضمّ عدداً من مشايخ دمشق وأعوانه من أمراء الجيش، وسفراء بعض الدول الذين صادف وجودهم وصول سبايا آل البيت^، فضلاً عن رجال من اليهود والنصارى، حيث كان يزيد مسروراً منتعشاً بزهوه وبنصره المزعوم، وما أن قُدّم أمامه الرأس الشريف حتى نكت ثنايا الإمام الحسين× على مرأى من أهل البيت^، واستنكر فعل يزيد هذا من قبل عدد من الحضور، بعضهم من صحابة الرسول’.
كلّ هذا حصل لسبايا آل البيت^، فزادهم معاناة فوق معاناتهم، وكأنهم ليسوا هم آل بيت النبي’ الذي أرسل رحمةً للناس جميعاً.
وعندما أُذِن لهم بالدخول إلى مجلس يزيد بن معاوية دارت حوارات عديدة بينهم وبين يزيد، من قبيل الحوار الذي دار بين يزيد والإمام علي بن الحسين (السجّاد)÷، وكذا بينه وبين السيّدة زينب بنت علي÷، فضلا عن حوارات أخرى بينه وبين بعض الحضور في المجلس، وهذا ما سنتحدث عنه في الفصل القادم.
سبايا آل البيت^
في مجلس يزيد بن معاوية
المبحث الأول: الأحاديث الأولى لسبايا آل البيت^ مع يزيد في مجلسه
المبحث الثاني: خطبة السيّدة زينب بنت علي÷ في مجلس يزيد
المبحث الثالث: خطبة الإمام علي بن الحسين (السجاد)÷ في مجلس يزيد
المبحث الرابع: أصداء الرفض لفعل يزيد بن معاوية
الفصل الرابع: سبايا آل البيت ^ في مجلس يزيد بن معاوية
الأحاديث الأولى لسبايا آل البيت^ مع يزيد في مجلسه
لقد كان لسبايا آل البيت^ في مجلس يزيد بن معاوية مواقف عبّرت عن صلابة المبادئ والإيمان بها والثبات عليها، رغم قتل أعزّتهم من ذويهم، ومن ثمّ سبيّهم في طريق طويل، عاشوا فيه أياماً مرّة، مرّت عليهم ثقيلة، بضربهم والإسراع في مشيهم، ومنعهم من الكلام، وربطهم بالحبال، والتشهير بهم من موضع إلى آخر، وأذاقوهم من التعب والجوع والعطش ما يصعب تحمّله؛ إذ لا وجود لناصر أو حامٍ من الرجال، وزاد على هذا الذي جرى على سبايا آل البيت^ استعراضهم في مدينة دمشق، حاضرة الحكم الأموي، في شوارعها وأسواقها، يتفرّج عليهم النّاس فرحين في ازدحام شديد لم يُر مثله. وهدف بني أميّة من ذلك هو القضاء على بيت النبوّة الذي يشكّل حاجزاً منيعاً أمامهم لا يمكن تجاوزه، ليستطيعوا ممارسة أفعالهم البعيدة عن الإسلام بحرية؛ إذ لا مانع ولا رادع، ومن ثمّ سيمثل بنو أميّة الإسلام بصورته الأموية، وهنا على الإسلام السلام.
لقد دخل الأمراء المصاحبون لقافلة سبايا آل البيت على يزيد بن معاوية، وأخبروه بخبر الإنتصار على الإمام الحسين× وقتله، وقتل أصحابه وسبي عياله، وتنفيذ أوامره بحمل كلّ ما تبقّى من عائلة الحسين ورؤوس القتلى إليه، بما فيهم رأس الإمام الحسين×([1067]).
وقد سمعت هند بنت عبد الله([1068]) حديث الأمراء مع زوجها يزيد بن معاوية، فتقنّعت بثوبها وخرجت إلى مجلس يزيد، فقالت: «يا أمير المؤمنين أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله| ؟! قال: نعم فأعولي([1069])عليه، وحدي([1070])على ابن بنت الرسول وصريحة([1071])قريش، عجل عليه ابن زياد فقتله، قتله الله»([1072]).
وبعد استعراض سبايا آل البيت في شوارع وأسواق دمشق، والذي امتدّ من الصباح الباكر إلى ما بعد الظهر، مع ما صاحبه من التعب الشديد للسبايا؛ وصلوا درج باب المسجد الجامع، وأُوقِفوا هناك إلى أن أذِنَ يزيد بن معاوية للأمراء بإدخال السبايا إلى مجلسه للتفرّج عليهم، والذي ضمّ أعداداً من النّاس، من زعماء الشام من بني أميّة وغيرهم، وأمراء الجيش، وسفير دولة الروم الذي صادف حضوره يوم دخول سبايا آل البيت في هذا المجلس([1073])، وبعض الزعماء من الأديان اليهودية والنصرانية([1074])، وكان بعضهم له مواقفه في اعتراضه على فعل يزيد الدموي.
لقد حرص يزيد بن معاوية على أن يظهر أمام الجالسين في مجلسه بأنّه يتمتّع بكامل هيبته وقوته وصحيح فعله، من خلال ما حقّقه من إنجازات بقتله الإمام الحسين× وقتل أصحابه وسبي عياله، إلّا أنّ ردود سبايا آل البيت^ على يزيد قد بدّدت تلك الهيبة والقوّة، ولا سيما ردود علي بن الحسين÷ وعمّته السيّدة زينب بنت علي÷، والتي شكّلت استمراراً للثورة الحسينية، فقد أظهرتتلك الردود الحقّ، ودافعت عنه، وتحدّت ظلم يزيد المتربّع على عرشه، مع علمهم بأنّ ليس له رادع من دين أو عقل، ومع ذلك فلم يخافوا منه ولا من بطشه، إذ إنّ حرسه المحيطين به ينفّذون أوامره بكل سرعة، وبدون تردّد أو تأمّل أو تعقّل، ومع ذلك فإنّ يزيد لم يتجرّأ على الردّ ردّاً قويّاً على علي بن الحسين÷ وعلى السيّدة زينب بنت علي÷، أو يأمر بفعل ما ضدهم؛ وذلك لضعف حججه، وحجم سوء فعله وذنبه، وخشيته من ردود الأفعال ضدّه.
فلمّا أراد أعوان يزيد إدخال ثقل الإمام الحسين بن علي÷ ـ من النساء وما بقي من أهل بيته، منهم أحد عشر غلاماً، والإمام علي بن الحسين([1075]) ـ على يزيد بن معاوية في قصره بدمشق، أتوا بحبال وربطوهم بمد تلك الحبال من عنق علي بن الحسين إلى عنق عمّته أمّ كلثوم بنت علي، ومن كتف زينب بنت علي إلى كتف ابنة أخيها سكينة بنت الحسين وبقية السبايا، وبعد إكمال ذلك ساقوا الجميع باتجاه قصر يزيد بن معاوية، وكانوا يضربونهم عند تأخّرهم في المشي، حتى أوقفوهم أمام يزيد وهو جالس على سرير الملك في قصره، وهم مقرّنون بالحبال، فقال علي بن الحسين ليزيد: «ما ظنّك بجدّنا رسول الله لو يرانا على مثل هذه الحالة؟! فبكى الحاضرون، فأمر يزيد بالحبال فقطّعت»([1076]).
إنّها صورة حال سبايا آل البيت^ المأساوية، يُقاد علي بن الحسين وعمّاته وأخواته وبقية الأسرى والسبايا من الصغار والكبار، بعد أن رُبِطوا بالحبال من عنق إلى آخر، ومن كتف إلى آخر، ويضربونهم كلّما قصّروا في مشيهم، بل ولأي سبب كان، ليدخلوهم على يزيد الذي صوّره بعضهم بأنّه يذرف الدموع على قتل الحسين، في حين لم يحرّك ساكناً ويأمر برفع الحبال، إلّا بعد أن كلّمه علي بن الحسين عن حال السبايا. ويبدو أنّ ربطهم بالحبال هذا كان يوم استُعرِضوا في دمشق، وهو غير ما ربطوا به بالحبال على مطاياهم في أثناء سيرهم في السبي من الكوفة إلى دمشق. ثمّ إنّ الحضور ما إن عرفوا بأنّ هؤلاء سبايا آل البيت^ ـ من خلال حديث علي بن الحسين مع يزيد ـ ضجّوا بالبكاء. ولمّا نظر يزيد بن معاوية إلى السبايا ـ عند حضورهم بين يديه ـ بدأ يسأل مَن هذه؟ ومَن هذا؟ فأُجيب بإسم كلّ واحد أو واحدة سأل عن اسمه أو اسمها([1077]).
وكانت السيّدة فاطمة بنت الحسين ÷ من بين السبيّات اللاتي أُدخِلنَ مجلس يزيد ـ كما هو معلوم ـ إلى جانب عمّاتها وأخواتها وبقية النساء، وبينما هي جالسة قام رجل شامي أحمر كان من بين الحضور ـ بما أنّ هذه النسوة هنّ سبايا، كما روّج الإعلام الأموي بذلك ـ فطلب من يزيد قائلاً: «يا أمير المؤمنين هَب لي هذه الجارية، فخافت فاطمة بنت الحسين من قول هذا الرجل، فلاذت بعمّتها زينب؛ لتحتمي بها آخذةً بثيابها، وزينب تعلم أنّ هذا لا يكون لهم، فردّت على الرجل الشامي قائلةً: كذبت والله ولؤمت، والله ما ذلك لك ولا له، فردّ يزيد غاضباً: كذبتِ إنّ ذلك لي ولو شئت أن أفعل لفعلت، فقالت زينب: كلا والله ما جعل الله لك ذلك إلّا ان تخرج من ملتنا وتدين بغيرها، فأزداد غضب يزيد ورد على زينب قائلاً: إيّاي تستقبلين بهذا؟! إنّما خرج من الدين أبوك وأخوك، فقالت له زينب: بدين الله ودين أبي ودين أخي اهتديت أنت وجدّك وأبوك إن كنت مسلماً، قال يزيد: كذبتِ يا عدوّة الله، فقالت له: أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك، وعندها استحيا وسكت. وأعاد الشامي طلبه، فزجره يزيد بقوله: أعزب([1078]) وهبَ الله لك حتفاً([1079]) قاضياً([1080])»([1081]).
وأشار مؤرّخون آخرون بأنّ البنت التي طلب الرجل الشامي من يزيد بن معاوية بأن يهبها له هي فاطمة بنت علي بن أبي طالب×، وليست فاطمة بنت الحسين([1082]).
لقد وُضِع رأس الحسين× في طشت من ذهب أمام يزيد بن معاوية، وأُجلِس النساء خلفه كي لا ينظرن إلى الرأس([1083])، ولكن عندما رأت النساء رأس الإمام الحسين× صحنَ وصاحت نساء يزيد أيضاً([1084])، وعرضت له بقية رؤوس القتلى، رأساً رأساً، ويزيد يسأل رأس مَن هذا؟ فيُخبَر عنه، ويُعرَّف به([1085]).
وقيل: إنّ يزيد بعد أن انفضّ مجلسه بعث برأس الإمام الحسين× إلى نسائه، فأخذته بنت له تُدعى عاتكة([1086])، فغسّلته ودهنته وطيّبته، فقال يزيد لها: «ما هذا؟ قالت: بعثت إليّ برأس ابن عمّي شعثاً، فلممته وطيّبته»([1087]).
ووجّهت السيّدة زينب بنت علي÷ كلامها إلى يزيد قائلةً: «يا يزيد، أما تخاف الله ورسوله من قتل الحسين؟! وما كفاك ذلك حتى تستجلب بنات رسول الله من العراق إلى الشام؟! وما كفاك حتى تسوقنا إليك كما تُساق الإماء على المطايا بغير وطاء؟! وما قَتل أخي الحسين أحدٌ غيرك يا يزيد، ولولا أمرك ما يقدر ابن مرجانة أن يقتله؛ لأنّه كان أقلّ عدداً وأذل نفساً، أما خشيت من الله بقتله، وقد قال رسول الله فيه وفي أخيه: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة من الخلق أجمعين؟! فإن قلت لا، فقد كذبت، وان قلت نعم، فقد خصمت نفسك، واعترفت بسوء فعلك. فقال يزيد: «ذريّة يتبع بعضها بعضاً، وبقي يزيد خجلاً ساكتاً»([1088]).
كأنّ في كلامها‘ ردّاً على محاولة يزيد إلقاء اللوم على ابن زياد، فهنا تؤكّد السيّدة زينب‘على أنّه هو الذي أمر ابن زياد، فكلاهما شريكان في أمر القتل.
إنّ وضع رأس الإمام الحسين× في طشت أمام يزيد بن معاوية في مجلسه، قد أثار نفوس سبايا آل البيت^ ولاسيما السيّدة زينب بنت علي÷فانبرت توضّح لحضور المجلس في مخاطبتها يزيد بن معاوية وتُؤنّبه على أفعاله، دون أن تكترث بحاجز الخوف الذي وضعته السلطة من إجراءات على النّاس، بحيث ركّزت في كلامها على التعريف بهؤلاء السبايا وصلتهم برسول الله تعالى، وأنّهم ليسوا من الخوارج، كما روّجت لذلك أبواق الإعلام الأموي. ثمّوجهت السيّدة زينب‘ عدداً من الأسئلة وضعت يزيد في زاوية حرجة، حيث وجّهت إليه لوما لاذعا ومتواصلا، من قتله للإمام الحسين، وزيادة على ذلك جلبه بنات الرسالة المحمّدية سبايا من الكوفة إلى دمشق.
كما فنّدت السيّدة زينب بنت علي÷ ادعاءات يزيد، وتنصّله من قتل الحسين وتحميل ابن زياد مسؤولية ذلك، حيث أكّدت السيّدة زينب على أنّ ابن زياد لم يكن إلّا منفِّذاً لأوامر سيده يزيد، ولم يكن بمقدور ابن زياد فعل ذلك من تلقاء نفسه؛ لقلّة عدده وضعف نفسه. وذكّرت الحضور في المجلس بحديث الرسول’ في الحسن والحسين وسيادتهما الشباب في الجنّة.
وهنا لا يمكن ليزيد أن يتنصّل عن جريمته، فهي الخصومة للنفس وسوء الفعل، ممّا جعل يزيد يفضل السكوت؛ إذ لم يجد جوابا لما ذكرته السيّدة زينب.
وعندما وضع رأس الحسين في طشت من ذهب أمام يزيد، أخذ ينكت بقضيبه ثغر([1089]) الحسين، وأنشد أبيات الحصين بن الحمام المري([1090]):
|
نفلّق هاماً من رجال أحبة |
فقال يحيى بن الحكم([1092]) وكان جالساً مع يزيد:
|
لهام بأدنى الطفّ أدنى قرابة |
فضرب يزيد في صدر يحيى بن الحكم، وقال: أسكت([1093]).
ثم أقبل على أهل المجلس وقال لهم: إنّ هذا ـ يعني الحسين بن علي ـ كان يفخر عليّ ويقول إنّ أبي خير من أب يزيد، وأمّي خير من أمّ يزيد، وجدّي خير من جدّ يزيد، وأنا خير من يزيد، فهذا هو الذي قتله، فأمّا قوله: بأنّ أباه خير من أبي فقد حاجّ أبي أباه، وقضى الله لأبي على أبيه، وأمّا قوله بأنّ أمّه خير من أمّ يزيد، فلعمري لقد صدق، إنّ فاطمة بنت رسول الله خير من أمّي، وأمّا قوله بأنّ جدّه خير من جدّي، فليس لأحد يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول أنّه خير من محمّد، وأمّا قوله بأنّه خير منّي فلّعله لم يقرأ: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)([1094]). ثمّ دعا بقضيب خيزران، فجعل ينكت به ثنايا الحسين وهو يقول: لقد كان أبو عبد الله حَسَن المضحك([1095])، وأنشد الشعر.
لقد قرأ يزيد بن معاوية أبياتاً كثيرة من الشعر أمام مجلسه، يُمجّد نصره بقتل الحسين بن علي، منها هذه الأبيات:
|
يا غراب البين ما شئت فقل |
وقد اختلف المؤرِّخون في نقل تلك الابيات([1100]).
وأمّا ما قصده يزيد بن معاوية من بيت الشعر الذي تلاه وأنّ بني هاشم وخاصّةً آل محمّد قد لعبوا بالملك باسم الرسالة والنبوّة، فهو ينفي نزول الوحي من السماء، ومجيء خبر من الله تعالى إلى محمّد.
وأشاع يزيد بين النّاس ـ كما كان يفعل أبوه معاوية من قبله ـ أنّ انتصارهم في الحروب يُعدّ دليلاً على أنّهم على الحقّ، ولذلك فهم مُؤيّدون من الله تعالى([1101])، وبسبب التغلّب على خصومهم داخلهم التكبّر والتجبّر. إلّا أنّ السيّدة زينب بنت علي÷ قد فنّدت هذا المعنى، وهزّت هذه الصورة من الأعماق، وهي ترى ما يفعله يزيد برأس أخيها الإمام الحسين، من تحريكهِ شفتيه بقضيب في يده، مترنّحاً بأبياتٍ من الشعر، ممّا جعلها تتّخذ أسلوباً عاطفياً مؤثّرا جدا على مَن حضر في المجلس، فراح يبكي مَن كان في المجلس عندما رآها قد هوت إلى جيبها وشقّته، ونادت بصوت حزين يقرح القلوب: «يا حسيناه، يا حبيب رسول الله، يا ابن مكّة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء وسيّدة النساء، يا ابن بنت المصطفى»([1102]).وفي قِبال هذا لم يكن ليزيد موقف يذكر، بل ظلّ ساكتاً([1103]).
ويُلاحظ على هذه الرواية ـ مع إقرارنا بانفعالات المرء إزاء ما يصيبه من مدلهمّات الزمان ـ أنّها تبقى محلّ نظر وتأمّل؛ لأنّها لا تُحاكي الشخصية العظيمة للسيّدة زينب بنت علي، فضلا عن أنّ حدوث ذلك هو مخالفة لوصيّة أخيها الإمام الحسين بن علي × ليل العاشر من المحرّم([1104]).
ويُوضّح ابن أعثم في إحدى رواياته ما يضمره بنو أميّة في قلوبهم تجاه آل بيت النبوّة، إذ يقول: «فتقدّم علي بن الحسين، حتى وقف بين يدي يزيد بن معاوية، وجعل يقول:
|
لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم |
فقال يزيد: صدقت يا غلام، ولكن أراد أبوك وجدّك أن يكونا أميرينِ، الحمد لله الذي أذلّهما وسفك دماءهما.
فقال له علي بن الحسين: يا ابن معاوية وهند وصخر، لم يزل آبائي وأجدادي فيهم الأمرة من قبل أن تلد، ولقد كان جدّي علي بن أبي طالب يوم بدر وأُحد([1105])والاحزاب([1106])بيده راية رسول الله، وأبوك وجدّك في أيديهما رايات الكفّار، ثمّ جعل علي بن الحسين يقول:
|
ماذا تقولون إن قال النبي لكم |
ثمّ قال علي بن الحسين: ويلك يا يزيد، إنّك لو تدري ما صنعت، وما الذي إرتكبت في أبي وأهل بيتي وأخي وعمومتي، إذا لهربت في الجبال، وافترشت الرمال، ودعوت بالويل والثبور، أن يكون رأس الحسين بن فاطمة وعلي منصوباً على باب المدينة، وهو وديعة رسول الله فيكم. فأبشر بالخزي والندامة غداً، إذا جمع النّاس في يوم لا ريب فيه»([1107]).
يتّضح ممّا تقدّم أنّ علي بن الحسين÷ لم يخشَ ولم يتردّد في كلامه مع يزيد بن معاوية وهو في مجلسه العريض، بل أشار إلى ما يتّصف به آل البيت^ من المحبّة لا الكراهية في قلوبهم لكل المسلمين، دون التمييز بين واحد وآخر، بين الأسود والأبيض والأحمر، إلّا بأعماله وأفعاله الموافقة للدين الإسلامي، على عكس بني أميّة، فإنّ حبّهم لِمَن لا يعارضهم في تولّيهم السلطة، ويقدّم لهم خدماته، ويتفانى في ذلك، وكرههم لِمَن يريدها ويبعدهم عنها، حتى لو كان ذلك بموجب الشرع الإسلامي.
وأمّا يزيد فيرى أنّ ما حصل بين آل بيت النبوّة^ وبني أميّة، هو الخلاف في مَن يقود الأمّة الإسلامية، وهذا ما صرّح به لعلي بن الحسين÷، بأنّ أباه وجدّه يطلبانِ الإمرة.
وهنا ذكّره علي بن الحسين÷ بأنّ جدّه الأول هو النبي محمّد’ قد بعثه الله تعالى رحمةً للناس كافّة، وأنّ جدّه الثاني هو علي بن أبي طالب× وصي النبي’ وأخوه قضى حياته مجاهداً في ظلّ راية الإسلام، وأنّ عمّه الحسن وأباه الحسين÷ هما سيّدا شباب أهل الجنّة وكفى، وهذا كلّه قبل أن يُولد يزيد. وأمّا أهله فهم صناديد الكفر والطغيان، وقد ضربتهم سيوف الإسلام، وكان أحدها سيف علي بن أبي طالب× في بدر وأُحد والأحزاب (الخندق)، حتى دخلوا كُرهاً في الإسلام، بعد أن قُتِل مَن قتُلِ من كبارهم. ثمّ ماذا يكون جواب يزيد وأعوانه يوم القيامة عندما تجمع الضحايا وجزّاروها؛ لفعلهم بذرية النبي’ من قتل الرجال، وسبي النساء والأطفال؟! أهكذا تحفظ وديعة النبي’؟! لكن هيهات؛ إذ لو وقف يزيد على فداحة فعله لهام على وجهه، واتّخذ من رمال الأرض فراشاً، ومن رياح السماء وعواصفها لحافاً؛ لهول ما ينتظره في الآخرة، حيث لا ندامة حينذاك، إنّما الخزي الأبديّ.
خطبة السيّدة زينب بنت علي÷ في مجلس يزيد([1108])
لقد ردّت السيّدة زينب بنت علي÷ على يزيد بن
معاوية في مجلسه ـ كما أشرنا آنفاً ـ والذي دفعها في إلقاء خطبتها في المجلس؛ هو
استمرار يزيد وتماديه في كفره وبشكل علني وأمام كلّ الحاضرين من المسلمين وغيرهم،
وتصرفاته غير المتّزنة، شماتةً وسروراً بقتل الحسين بن علي÷، والتي تُثير أشجان
ومشاعر سبايا آل البيت^، ومنهم
زينب بنت علي÷. فقد كشف يزيد عمّا في نفسه من أنّ قتله الحسين وسبي عياله هو
انتقام من رسول الله’، وبدأ يردّد من الشعر أبياتاً
لعبد الله بن الزبعرى([1109])التي
قالها بعد معركة أحد، منها:
|
ليت أشياخي ببدر شهدوا |
ثم زاد على تلك الابيات بيتاً من عنده، فقال:
|
لستُ من عتبة إن لم أنتقم |
فعندما سمعت زينب‘ ترديده هذه الأبيات، والتي يُصرّح فيها بعداوته للإسلام ونبيّه’، وعدم الإيمان برسالته، والأخذ بثأر أجداده القتلى في بدر، وعبثه برأس الحسين×، وعلى مسمع وأنظار من كان في المجلس، هنا وجدت زينب‘ نفسها لا بدّ وأن تقوم بدور الردّ على تلك الإنتهاكات الباطلة، وتُعلِن عن صيحة حقّ لم تسمعها من الحاضرين، وتفنّد كلّ إدّعاءاته بانتصاره المزعوم المسرور به، وبالتالي فإنّها أكّدت استمرار الثورة الحسينية التي رُويت بالدماء الزكية وبالتضحيّات الكبيرة، والتي جعلت يزيد مهزوماً بمقاييس الحقّ ومبادئه، فوجّهت كلامها إليه وإلى مَن يسمع، فقد دمّرت عقيلة بني هاشم ÷ في خطبتها جبروت الطاغية([1112])، وألحقت به الهزيمة والعار، وعرّفته أنّ دُعاة الحقّ لا تنحني رؤوسهم أمام الطغاة الظلمة([1113]).
ابتدأت السيّدة خطبتها في مجلس يزيد بن معاوية بحمد الله تعالى ربّ العالمين، ثمّ الصلاة على محمّد سيّد المرسلين وخاتم النبيّين، وأكّدت على أنّ الرسول’ هو جدّها، وهي بهذا تريد تعريف الحاضرين بأنّ هذه العائلة التي قُتِل رجالها وسُبِيت وأُسِرت نساؤها وأطفالها من قبل بني أميّة هي ذريّة رسول الله، لا من بلاد الكفر والشرك. فبينما كان يزيد بن معاوية يستشهد في كلامه بأبيات من الشعر، متفاخراً بما فعله من قتله ذرية الرسول’ وسبي عياله، نجد السيّدة زينب بنت علي÷ تردّ عليه بآي من القرآن الكريم، وتذكّره العاقبة التي يؤول إليها كلّ شيء، فإنّ الذين أساؤوا إلى أنفسهم بكفرهم بالله تعالى، والإستهزاء بآياته، وتكذيب رسله، وارتكابهم الذنوب،ومعاصي السوء؛ سيؤول حالهم إلى النار. وإنّ مفردة السوء التي وردت في الآية التي ذكرتها السيّدة زينب بنت علي÷ هي إحدى مسمّيات النار([1114]).
وفي قول السيّدة زينب‘: «أظننت([1115])يا يزيد! حين أخذت علينا أقطار([1116])الأرض وآفاق([1117])السماء، وأصبحنا نُساق كما تُساق الأسارى([1118])»، نُلاحظ أنّها قد خاطبت يزيد بن معاوية باسمه الصريح، فهي لم تخاطبه بكلمة: يا (أمير المؤمنين) أو: أيها (الخليفة)، أو بأي عبارة أخرى من العبارات التي تدلّ على منصبه؛ موضحةً بذلك عدم اعترافها بتبوّؤه هذا المنصب، وهذا هو رأي آل البيت^ في يزيد ومعاوية ومنصبهما، ومن جاء بعدهما من بني أميّة؛ لأنّه لا يستند إلى مستند شرعي، ليس بنظر آل البيت وحسب، بل عند المسلمين، لأنّهما من أبناء الطُلقاء([1119]).
ثمّ بيّنت السيّدة زينب حال سبايا آل البيت^ وهم يقطعون طريق السبي من الكوفة إلى بلاد الشام، من المعاناة والضيق والحصار الذي فُرِض عليهم، في مختلف مواضع الأرض ونواحيها التي مرّوا بها، فضلاً عن نواحي السماء، وهو تعبير مجازي يدلّ على مدى المعاناة التي عاشها سبايا آل البيت^، لأنّ يزيد لم يكن بإمكانه أن يتصرّف بنواحي السماء، وهكذا جعلهم يعيشون في محنة قاسية لا تليق بهم، وكأنهم أسرى وسبايا الكفّار جيء بهم من أحد مواضع الثغور التي يفتحها المسلمون عادةً في جهادهم.
وفي قولها:«أنّ بنا على الله هواناً([1120]) وبك عليه كرامة([1121])؟! وأنّ ذلك لعظم خطرك([1122]) عنده، فشمخت بأنفك([1123])، ونظرت في عطفك([1124]) جذلان([1125]) مسروراً، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة([1126]) والأمور متّسقة([1127])، وحين صفا([1128]) لك ملكنا وسلطاننا».
أشارت السيّدة زينب في لوحة حسيّة إلى يزيد، ومثّلت المعاني التي ذهب إليها من غرور واستعلاء واعجاب بالنفس في اعتقاده لمّا رأى آل بيت النبوّة مغلوبين، ووجد الغلبة والظفر لنفسه؛ أنّ له عند الله تعالى جاهاً وكرامة، وأنّ ليس لأهل البيت مكانة وجاه إلّا الذلّ والخزي، ولذلك كانت له الغلبة والنصر عليهم حتى قتل رجالهم، وسبى نساءهم، حيث كان كلّ الذي حصل بعين الله، وهو دليل ـ بزعمه ـ على علوّ منزلته عند الله تعالى، ممّا جعله يشعر بالعزّ والتكبّر، وينظر بنوع من الأنانية والغرور، حين رأى الدنيا له مجتمعة، والأمور لديه منتظمة. كما أنّ نجاح خطّته في القضاء على خصمه الشرعي ابن بنت النبي وسبي نسائه جعله يتباهى بملكه وسلطانه، إلّا أنّه تناسى أن ما ادّعاه لنفسه إنّما أخذه غصبا؛ لأن الجميع يعلم أنّ حقّ خلافة رسول الله هو في أهل البيت^.
ثمّ أرادت السيّدة زينب أن توضّح ليزيد ما كان عنه غائباً، بأن الأمر ليس كما يعتقد أو يظن، وليس تسرّعه في العمل أو في إبداء رأيّه صحيحاً منه، فلا بدّ من التمهّل وعدم العجلة، فوضّحت له حقيقة الأمر([1129])، ثمّ ذكّرته بهذه الآية الكريمة: (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)([1130])، نملي: أي يطيل الله تعالى لهم المدّة([1131])، أو يطيل أعمارهم، ويجعل الساحة مفتوحة أمامهم، إنّما يطيل أعمارهم ومدّة سلطتهم وحكومتهم؛ لتكون عاقبة أمرهم هي ازدياد الإثم والمعاصي في سجلّ أعمالهم، ولهم عذاب مهين، أي: يجزيهم الله تعالى في جهنم عذاباً ممزوجاً بالإهانة والتحقير([1132]). وفي قولها: «أمِنَ العدل يا ابن الطلقاء([1133])! تخديرك([1134])حرائرك([1135])وإمائك([1136])،وسوقك([1137])بنات رسول الله سبايا؟! قد هتكت([1138])ستورهنّ([1139])،وأبديت وجوههنّ، يحدى([1140])بهنّ من بلد إلى بلد، ويستشرفهنّ([1141])أهل المناهل([1142])والمناقل([1143])، ويتصفّح([1144])وجوههنّ القريب والبعيد، والدنيّ([1145])والشريف،ليس معهنّ من رجالهنّ وليّ([1146])،ولا من حماتهنّ حميّ([1147])».
أمّا هدف السيّدة زينب بنت علي÷ من قولها: «أمِنَ العدل يا ابن الطلقاء» فإنّها تريد أن تُذكّر يزيد بموقف الرسول’ مع مشركي قريش، ومنهم عدد من رجالات بني أميّة، عند فتح مكّة عام 8هـ/629م، والذي أتّخذ طابع العفو والسماح، بالرغم من أنّ المشركين كان موقفهم من الإسلام والمسلمين عدائيّاً، وكان بإمكان الرسول’ أن يتّخذ الإجراء المناسب مع المشركين الذي يقرّه الشرع الإسلامي، وكان من البارزين منهم أبو سفيان صخر بن حرب، وهو جدّ يزيد بن معاوية، وقد سعى لتحريض قريش لمحاربة الإسلام في عدّة حروب ضدّ الرسول’ والمسلمين([1148])، إلّا أن الرسول’ عند دخوله مكّة ومع ما بدر من أهل مكّة وخاصّة من أبي سفيان وأمثاله، التفت إليهم قائلاً: «يا معشر قريش، ما ترون أنّي فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، أخ كريم، وابن أخ كريم، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء»([1149])، وكان فيهم أبو سفيان وابنه معاوية، وبما أنّ يزيد هو ابن معاوية وحفيد أبي سفيان، لذلك أطلقت عليه السيّدة زينب (ابن الطلقاء)، تذكّره بذلك بجدّه وأبيه، ولتبيّن له ولمجلسه ماذا فعل جدّها رسول الرحمة بأجداد يزيد من العفو والسماح، وماذا فعل أحفاد الطلقاء بأحفاد الرسول من القتل، وأي قتل؟! إنّه القتل الجماعي للكبار والصغار، والسبي، وأي سبي؟! إنّه سبي لآل بيت الرسول’ من النساء الثواكل والصبيان اليتامى من الطفّ إلى الكوفة وإلى دمشق.
إنّ يزيد يخلو من صفة العدل، ولا يُرجى منه ذلك، إلّا أنّ السيّدة زينب بنت علي÷ أرادت منه أن يكون عادلاً ما دام تصدّى للمسؤولية، وبالتالي كيف سوّلت ليزيد نفسه أن يعرض بنات الرسالة وعقائل النبوّة ومخدّرات الوحي إلى كشف سترهنّ، ويكنّ محطّ نظر وتأمل النّاس الأجانب إلى ملامحهنّ، بمستوياتهم المختلفة داخل المدن عند استعراضهنّ، أو في طريق السبي الطويل من بلد إلى آخر، مروراً بالطرق الجبلية، ومواضع المياه التي تتزوّد منها القافلة، مع التشهير بهنّ، وقد كنّ لا يرى أحد لهنّ ظلاً، وفي الوقت الذي يحافظ يزيد على ستر نسائه وإمائه الساكنات في قصره، ولا تراهن عيون الغرباء، وسِيقت نساء آل البيت بطريقة مذلّة، وحثهنّ على السير مسرعين بقوّة من الخلف، ومع هذا الحال المرّ لا يوجد لهنّ من الرجال أحد، لتدبير شؤونهنّ وحمايتهنّ من الأعداء، ودفع الأخطار عنهن؛ لأنّهم كلّهم قد قُتلِوا في الطفّ، ولم يبق إلّا عدد من الصبيان، والإمام علي بن الحسين÷ الذي كان مريضاً. وكلّ هذا الذي جرى إنّما هو بأمر يزيد وبإشراف أعوانه، الذين أغدق عليهم بجوائزه؛ ممّا جعلهم يتسارعون فيما بينهم لتنفيذ أوامره.
وفي قولها‘: «وكيف
ترجى([1150])المراقبة([1151])ممَّن لفظ([1152])فوه([1153])أكباد
السعداء،
ونبت([1154])لحمه بدماء الشهداء»، أشارت السيّدة زينب‘ إلى أنّ يزيد قد خلا قلبه من الخوف من الله تعالى، ولا
يتوقّع منه غير ذلك؛ لأنّه امتداد إلى سلوكيّات ما حدث في معركة أُحد بين المسلمين
ومشركي قريش، ومعهم أبو سفيان جدّه، وقد استُشهِد في هذه المعركة الحمزة بن عبد
المطّلب([1155]) عمّ الرسول محمد’، حيث جاءت هند بنت عتبة([1156]) ـ أم معاوية وجدّة يزيد، التي كانت حاضرة في معركة اُحد ـ إلى جسد الحمزة
بعد أن سقط شهيداً، وشقّت بطنه، وأخرجت كبده، وأخذت قطعة منه ووضعتها في فمها،
وعضتها بأسنانها، وحاولت أن تأكلها([1157])؛ بسبب حقدها المتأجّج في صدرها، لقتل أبيها وعمّها وأخيها في معركة بدر([1158])، فماذا ينتظر من حفيد تلك المرأة من مواقف إزاء بيت النبوّة رافعي رايات
الإسلام؟! إلّا الحقد وارتكاب الجرائم الكبيرة بحقّهم.
وفي قولها: «وكيف يستبطأ([1159])في بغضنا أهل البيت مَن نظر إلينا بالشنف([1160])والشنئآن([1161])والإحن([1162])والأضغان([1163])؟! ثمّ يقول غير متأثم([1164])ولا مستعظم([1165]):
|
لأهـلّوا وأستهلّوا فرحـاً |
منحنياً على ثنايا([1166]) أبي عبد الله تنكتها([1167]) بمخصرتك([1168])، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت([1169]) القرحة([1170])، واستأصلت([1171]) الشأفة([1172]) بإراقتك دماء ذريّة آل محمّد، ونجوم الأرض من آل عبد المطّلب».
نستشفّ من بيان السيّدة زينب بنت علي÷ أنّ يزيد وأهله لا يتأخرون ولا يتردّدون، بل يسارعون في الإفصاح عن شدّة كرههم وحقدهم الثابت في الصدور، وبغضهم لآل بيت النبي، فهم في حالة الإنشراح بقتلهم الحسين ورجال أهل بيته وأنصاره، وسبي العقائل من نسائه، ويردّد يزيد أبياتاً من الشعر، ويضيف إليها أبياتاً أخرى من نظمه، دون تحرجه من الآثام وعظمة ارتكابها، مخاطباً سلفه الذين أخذتهم سيوف الإسلام، مبشراً لهم بأخذ ثأرهم. ثمّ تمادى يزيد عندما وضع رأس الحسين في طشت أمامه، وراح بعصاه يضرب ويلعب بشفتيه وأسنانه، كلّ ذلك كان على مرأى من ثواكل ويتامى نساء أهل بيته، وهو في أوجّ انتعاشه وسروره، ولا رادع من حياء أو من خشية الله تعالى. وقد أجّج في ذلك هيجان الأحزان من جديد، وفجّر دموع النسوة اللائي يعانينَ من الفقد والألم والوحدة والمآسي، فاستولى عليهنّ البكاء والنحيب، لأنّ الحسين ـ وفقاً لوصف أخته السيّدة زينب بنت علي÷ ـ هو عندهنّ نجم من نجوم الأرض، وما أروع هذا الوصف! لأنّ الحسين وجهٌ مشرقٌ وضّاء، ووجهةٌ متلألئة لآل عبد المطّلب بن هاشم. ثمّ إنّ يزيد بقتله الحسين لم يتمكّن من قطع شجرة النبوّة التي تحظى بعناية الله تعالى وحمايته، وستستمر في أولاد الحسين وأحفاده.
وفي قولها: «أتهتف([1173])بأشياخك؟ زعمت تناديهم، فلتردنّ وشيكاً موردهم، ولتودنّ أنّك شللت([1174])وبكمت([1175]) ولم تكن قلتَ ما قلتَ»، أشارت السيّدة زينب‘ إلى أنّ يزيد كان يرفع صوته عالياً، منادياً سلفه من شيوخ الكفر الذين أخذتهم سيوف الإسلام يوم كانوا أعداء أشداء له، وكان يردّد شعراً: ليت أشياخي ببدرٍ شهدوا... وتمنى يزيد حضورهم ليرَوا انتصاره المزعوم، وقد أخذ بثأرهم من آل محمّد، وليباركوا له يمينه التي لا تشلّ، مع أنّ أشياخه هم الذين كانوا يخرجون من مكّة إلى المدينة؛ لقتال المسلمين ونبيهم. ثمّ استشرفت زينب حال يزيد ومصير مستقبله، بأنّه سيكون حال أشياخه من حيث العقوبة الإلهية، وسوف يتمنّى بأنّه لو أُصِيبَ بشلل جسمه وقطعت يده ولم يفعل ما فعله، من ضربه ثنايا وشفَتَي الحسين، ويتمنّى أيضاً بأنّه لو كان أبكم أخرس ولم يقل ما قاله بحقّ آل البيت.
وفي قولها: «اللهمّ خُذ بحقّنا، وانتقم([1176])ممَّن ظلمنا، واحلل([1177])غضبك بمَن سفك([1178])دماءنا، وقتل حماتنا»، توجّهت السيّدة زينب بنت علي÷ إلى الله تعالى بالدعاء، وهو المطّلع على خفايا الأمور وظواهرها، داعية إيّاه أن يردّ حقّهم وينتصر لهم ممَّن ظلمهم، وينزل غضبه على مَن هدر دماء رجالهم.
وفي قولها: «فوالله
ما فريت([1179]) إلّا جلدك، ولا
جزرت([1180]) إلّا لحمك،
ولتردنّ
على رسول الله بما تحمّلت من سفك دماء ذريّته، وانتهاك([1181])حرمته([1182])في لُحمته([1183])وعترته([1184])، وليخاصمنَّك([1185])حيث يجمع
الله تعالى شملهم([1186])، ويلمّ
شعثهم([1187])، ويأخذ
لهم بحقّهم، (وَلَا تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ)([1188])، فحسبك([1189])بالله
حاكماً، وبمحمّد خصيماً، وبجبرئيل ظهيراً([1190])». أخذت
السيّدة زينب‘ تعدّد في خطبتها الجرائم التي ارتكبها يزيد، وتذكّره أنّها ستعود
عليه بالخسران في الدنيا والآخرة، وأنّ سروره فيها لا يدوم؛ لأنّ عقاب جريمته
عبارة عن تفتيت جلده، وتقطيع أجزاء من لحم جسمه، وسيقدم على رسول الله وهو محمّل
بكبائر الذنوب؛ بهدر دماء ولده وبني عمّه من بني هاشم، فضلاً عن تعرّضه لحُرمة
وقرابة نساء رسول الله، وسيُحاسب يزيد حساباً عسيراً في المحكمة الإلهية، والتي
فيها الحاكم الله تعالى، والخصم ووليّ دم الحسين وأصحابه هو الرسول’ وجبرائيل
وصالح المؤمنين.
وفي قولها: «وسيعلم من سوّل([1191])لك ومكنّك([1192])من رقاب المسلمين، إنّ (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا)([1193])، وأيّكم (شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا)»([1194]). ترى السيّدة زينب‘ عدم شرعية توليّة يزيد الخلافة، وتسلّطه على رقاب المسلمين، بل وعدم شرعية سلطة مَن وهب يزيد هذه السلطة، وتقصد به أباه معاوية. وبهذا فإنّ كلا الإثنين قد تحمّل الجنايات بقتلهم الأبرياء من المسلمين، وسيكون العذاب الأكثر لمعاوية؛ لمعرفته بإمكانيات ولده يزيد، التي لا تمكّنه من تولّي الحكم، لما يتّصف به من الفسق، وجهله في إدارة الدولة. ولعلّ هذا المعنى هو المقصود في قول السيّدة زينب المقتبس من قوله تعالى: (فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا)([1195]).
وفي قولها: «ولئن جرّت عليّ الدواهي([1196])مخاطبتك، فإنّي لأستصغر قدرك([1197])، واستعظم تقريعك([1198])، واستكبر توبيخك([1199])، لكنّ العيون عبرى([1200])، والصدور حرّى([1201])»، بيّنت السيّدة زينب‘ أنّ وقوفها وكلامها مع يزيد لم يكن أمراً طبيعياً، بل بسبب ما جرّه الدهر عليها، وتقلباته من المصائب ونوازله الكبيرة، لأنّها في منتهى العفّة والخدر، ويزيد في غاية اللؤم والحقارة، ومن الصعب عليها مخاطبة رجل نازل القدر والمكانة، ولكنّها مضطرّة إلى ذلك. ومع عظم توجيه الملامة، إلّا أنّها أرادت أن تبيّن له فظاعة أفعاله، ومنها ضربه ثنايا الحسين× أمام الحاضرين في مجلسه، وأنّ السيّدة زينب‘ وبقية السبايا ـ وهم في هذا الحال ـ يعيشون الحزن والألم بعيون دامعة، وصدور ملتهبة بالحرارة، وقلوب مقرحة؛ بسبب قتل الحسين× بلا ذنب، وبتلك الكيفية الفجيعة، وما تعرّضت له سبايا آل البيت^ بعد قتل رجالهم، وهذا ـ حالات الحزن والألم ـ أمر طبيعي لكل إنسان في الكون باقٍ على فطرته الأولية، التي فطر الله تعالى النّاس عليها.
وفي قولها: «ألا فالعجب كلّ العجب لقتل حزب الله النجباء([1202])بحزب الشيطان الطلقاء، فتلك الأيدي تنطف([1203])من دمائنا، وتلك الأفواه تتحلّب([1204])من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل([1205])، وتعفوها([1206])الذئاب، وتؤمّها الفراعل([1207])»، تتعجّب السيّدة زينب‘ أن يُقتل الكرماء الأسخياء، وهم الحسين وأصحابه، من قبل أُناس يُطلق عليهم الطُلقاء، وهم آل أبي سفيان وأعوانه، الذين يشكّلون حزب الشيطان، وأن أيديهم تقطر وتسيل من دماء قتلى الطفّ. والظاهر أنّ كلام السيّدة زينب‘هذا هو استعارة بلاغية، وتعني به تلك الأيدي والأكف التي كانت تضرب بسيوفها ورماحها أجسام آل رسول الله، الحسين ورجال بيته وأصحابه، فتتقاطر سيوفهم ورماحهم من دماء أولئك الكرماء الطيّبين، الذين بقيت أجسادهم الطواهر الزواكي ثلاثة أيّام على ثرى الطفّ، ممتنعة عن افتراس الحيوانات لها، والتي تأتيها مرّة بعد مرّة، وتدور حواليها، بعكس جنود عمر بن سعد. فقد وصفت السيّدة زينب‘ الواحد منهم كأبن الضبع في شراسته، عندما رضّوا جسد الحسين يوم الطفّ بحوافر خيولهم([1208]).
وفي قولها: «فلئن اتخذتنا مغنماً([1209])، لتجدنا وشيكاً مغرماً([1210])، حين لا تجد إلّا ما قدّمت يداك، (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)([1211])، فإلى الله المشتكى، وعليه المعوّل([1212])». أشارت السيّدة زينب‘ إلى أنّ يزيد قد أمر جلاوزته بعد قتل الحسين وأصحابه بسبي ما تبقّى من أهل بيت الحسين، والقدوم بهم إلى دمشق مقرّ الحكم الأموي. وفي طريق السبي تعاملوا مع سبايا آل البيت كغنيمة حصل عليها الأمويون لانتصارهم في حربهم مع الحسين وقتله، ولكن، وفي القريب العاجل، سُرعان ما تتحوّل تلك الغنيمة إلى دَين في رقبة يزيد لا يمكن التخلّص منه، لأنّ هذا الدَين عبارة عن ذنوب ومعاص، وفي مقدّمتها قتل الحسين وأصحابه وسبي عياله، وسيُسأل عنها في محكمة العدل الإلهية، والتي لا يُظلم فيها أحد، وعندها سيجد يزيد نفسه وحيداً ذليلاً مهاناً، بغير محامٍ يدافع عنه، وقد استعان عليه آل البيت بالله تعالى واتكلوا عليه، وهو الملجأ والأمل لهم، وسينتقم من أعدائهم، لأنّه الشاهد على ما حدث لهم على يد يزيد وأعوانه.
وفي قولها: «فكد كيدك([1213])، واسع سعيك([1214])، وناصب([1215])جهدك([1216])، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا([1217])، ولا ترحض([1218])عنك عارها، ولا تغيب منك شنارها([1219])».
أشارت السيّدة زينب‘ بلهجة صارمة، يفيح منها صوت التحدّي ليزيد، بأنّه يظلّ يفعل خفيةً حيلةً ومكراً شيئاً ما، يريد أن يضرّ به غيره، إلّا أنّه كسب متعب وضارّ له. وهذا استشراف دقيق من سيّدة سبيّة واثقة من نفسها، بأنّ أعمال يزيد ونشاطاته اللاحقة ستكون فاشلة، ولم يتوصّل إلى أيّ هدف من أهدافه، بل ترجع عليه بعكس ما كان يصبو إليه، فكرسيه يتزعزع، وسلطته تضعف، وسوف لا يصل إلى الهدف الذي حلم به هو ومَن كان قبله، من استئصال شجرة النبوّة من جذورها وفروعها وأغصانها وأوراقها، وعدم إبقاء صغير أو كبير من آل بيت النبوّة، وهذا لا يتمّ له، لأنه ومع بذله جهوداً كبيرة لا يصل إلى ما يريد تحقيقه، إذ إنّ آل البيت قد أُحيطوا بعناية ربانية لا تخرق، وإنّ جريمته التي ارتكبها لا يمكن أن يغسلها غسلها، فهي أقبح عيب وعار، بل تظلّ تلاحقه وأعوانه ومَن سيأتي من بعده على المنهج ذاته.
وفي قولها: «فهل رأيك إلّا فند([1220])! وأيامك إلّا عدد([1221])! وشملك إلّا بدد([1222])! يوم ينادي المنادي: ألا لعنة([1223])الله على الظالمين»([1224])، أشارت السيّدة زينب‘، إلى أنّ يزيد خاطئ في محاولاته وتخطيطه للتخلّص من آثار جريمته، وأنّ أيامه في حكمه أو في حياته قليلة ومعدودة، وأنه قريب إلى الموت والهلاك، وسيلاقي جزاء أعماله.
وفعلا تحقّق ما وعدت به السيّدة زينب‘، حيث إنّه لم يلبث في الحكم بعد جريمته هذه إلّا ثلاث سنوات وتسعة أشهر وأياماً قليلة([1225])، فلا فائدة من وقوف حاشيته له، حيث تفرقت عنه وذهب ما كان يتهنّأ به معهم، ويوم ينادي المنادي يوم الحساب بطرد وإبعاد الظالمين من رحمة الله تعالى وعطفه ومغفرته وعفوه.
وفي قولها: «فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والرحمة، ولآخرنا بالشهادة والمغفرة، وأسأل الله أن يكمل لهم الثواب([1226])، ويوجب لهم المزيد وحسن المآب([1227])، ويختم بنا الشرافة([1228])، إنّه رحيم ودود، (وحسبنا الله ونعم الوكيل)([1229])، (نعم المولى ونعم النصير([1230]))»، أشارت السيّدة زينب‘ في آخر خطبتها إلى الثناء على الله تعالى، الذي كتب لجدّها النبي بسعادة الآخرة، ولأخيها الحسين بن علي بالشهادة، وسألت الله سبحانه وهو مرجعهم أن يجزي خيراً أولئك الذين قدّموا أرواحهم في سبيله، وأن يكون لهم علوّ المكان في جنّات النعيم، وهي ترى في الله ذلك الرحيم، الودود، الوكيل، الولي والنصير.
بعد أنِ انتهت السيّدة زينب‘ من خطبتها بدأ الحاضرون يترقّبون ردود فعل يزيد على تلك الخطبة، وخاصّةً أنّه كان يريد من لقائه بسبايا آل البيت إظهار قوّته وانتصاره وشماتته بهم أمام حضور مجلسه، إلّا أنّ هذا اللقاء تحوّل إلى هزيمة له، فانعقد لسانه عن الردّ على خطاب السيّدة زينب بنت علي÷؛ إذ إنّه رأى أنّ الإجابة والتعليق على الخطاب يسبّب له المزيد من الهزائم والإنكسار أمام شيوخ القبائل، وأمراء جيشه، وسفراء الدول، وبعض رجال الديانات الأخرى الحاضرين في مجلسه، لذا فإنّه لم يخلق حوارا بينه وبين السيّدة زينب‘، التي أبدعت في إظهار قدرة خطاب كلّه سبق واستدلال منطقي وعقلي، وتمكّنت من اقناع الحاضرين بأنّهم آل بيت النبوّة، وما جرى عليهم ظلم كبير بموجب الحقائق التي تلتها، ولا يمكن انكارها، وجعلت يزيد يشعر بالهزيمة رغم تكبره وتجبره، ولم يسجّل له ردّاً سوى ردّ عاجزٍ في قوله:
|
«يا صيحة تحمد من صوائح |
إنّ المتأمل في قول يزيد هذا لايجد مناسبة له في مقام هذا اللقاء، لأن السيّدة زينب‘ لم تكن من النساء اللواتي يحترفنَ النياحة حتى ينطبق عليها هذا القول. ولعلّ يزيد لم يتوقّع من امرأة سبية مكسورة أن تغمسه في بحار الخزي والعار، ولم يتمكّن يزيد أن يغسل عن نفسه تلك الوصمات التي وصمته بها في خطبتها، سوى ردّه على السيّدة زينب‘ بشعر غير مناسب ولا ينطبق على السيّدة زينب‘.
وخلاصة القول، إنّ خطبة السيّدة زينب بنت علي÷ في مجلس يزيد، تُعدّ من المواقف البطولية الرائعة لتحدّيها جبروت الظلم والطغيان، وتحطيمها كبرياء وغرور يزيد بن معاوية، إذ جعلته حائراً في إيجاد ردّ مناسب عليها، إلّا أنّه لم يزد على تمثّله ببيت الشعر الآنف الذكر. وبهذا حققت السيّدة زينب‘ هدفاً رسالياً من خلال توضيح حركة الحسين وأهدافها، وهذا نصر ساحق على يزيد وهو في ذروة سلطته، وقد أفحمته مرّة بعد أخرى، ممّا سبّب له حرجاً كبيراً بين حضّار مجلسه، إذ بيّنت جهله وضعفه في تدبير وإدارة شؤون الدولة وعدم أهليّته لذلك، فضلاً عن جهله في الشرع الإسلامي، والذي يجب أن يكون فيه على قدر كبير من المعرفة؛ كونه خليفة المسلمين كما يدّعي، ولو كان ذلك عنده لما صحّ سبي نساء المسلمين في الحروب المخالف للشرع إبّان حكمه، بل تجاوز إلى أبعد من ذلك بسبيه عقائل بيت النبوّة([1232]).
خطبة الإمام علي بن الحسين (السجّاد)÷([1233]) في مجلس يزيد
لقد ظهر يزيد بن معاوية ضعيفاً أمام حضّار مجلسه؛ إذ لم يتمكّن من الردّ على السيّدة زينب‘ وهي تدلي بخطابها الذي بيّنت فيه زيف ادّعاءاته، وأقنعت مَن سمع خطابها بأنّهم آل بيت النبوّة، وليسوا سبياً من الخوارج، وقد تعرّضوا إلى ظلم كبير بقتل رجالهم وسبي نسائهم، وعند ذلك أراد يزيد أن يموّه على الحضور، فدعا أحد الخطباء، وأمر بإحضار منبر له، وأوصاه عند جلوسه على المنبر أن يتحدّث عن مساوئ الحسين وأبيه علي بن أبي طالب وأفعالهما.
وعند صعود الخطيب المنبر، بدأ خطبته بحمد الله تعالى والثناء عليه، ثمّ أطال كلامه ذامّاً ومعيباً في علي وولديه الحسن والحسين، وزاد في مدح معاوية بن أبي سفيان وولده يزيد، ونسب إليهما كلّ جميل، وشدّد في ذلك. فلمّا سمعه علي بن الحسين÷، صاح به: «ويلك أيّها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوّأ مقعدك من النّار»([1234]).
ويبدو أنّ يزيد بن معاوية كان يريد إعادة جوّ مجلسه إلى ما قبل خطبة السيّدة زينب‘ حيث ظهر مزهواً مسروراً بانتصاره المزعوم؛ إذ إنّ خطبة السيّدة زينب‘ أدّت إلى انكساره وانكسار أعوانه، لذا طلب يزيد من الخطيب وأمره بصعود المنبر أمام الحاضرين من أجل رفع شأن آبائه وأجداده، والنيل والحطّ من المكانة الرفيعة والسامية التي يتمتّع بها سبط النبي الحسين بن علي وأهل بيته، وإزاء فعل يزيد هذا لم يتردّد الإمام علي بن الحسين÷ ولم يخشَ منه بل ولم يحسب له حساباً، فصاح بالخطيب ـ وهو من وعّاظ السلاطين ـ موبّخاً له على شرائه رضاء يزيد دون قول الحقّ، ودون اكتراثه وخوفه من الله تعالى وسخطه عليه.
ويتبيّن لنا من خلال هذه الأجواء أنّ مجلس يزيد بن معاوية ـ الذي عقده وضمّ شيوخ الشام، وأمراء جيشه، والآخرين من ذوي الشأن، ثمّ دخول سبايا آل البيت^عليه ـ كان في قصره، ولذلك أمر بإحضار منبر للخطيب الذي كلّفه بمهمّة الخطبة التي يبيّن فيها المناقب المزعومة لآبائه، وتسويق الكذب لصنع مثالب في الحسين وآل بيته، فلو كان مجلس يزيد قد عُقِد في المسجد الجامع لما أمر يزيد بإحضار منبر للخطيب، ولأمره بصعود المنبر مباشرةً.
وهنا لم يتّخذ الإمام علي بن الحسين÷جانب السكوت إزاء ما يجري أمامه، بل طلب من يزيد أن يسمح له بصعود المنبر ـ والذي وصفه بالأعواد ـ ليتحدّث بحديث يكون لله تعالى رضاً، ولحضّار المجلس أجرا وثواباً([1235]).
ونلاحظ أن علي بن الحسين÷ قد خاطب يزيد بن معاوية باسمه الصريح، كما فعلت عمّته السيّدة زينب‘، فلم يخاطبه بكلمة أيّها الخليفة، أو يا أمير المؤمنين، أو أيّ كلمة تدلّ على الإحترام، وهذا دليل على عدم اعترافه بمنصبه الذي يتولّاه، ثمّ إنّ عليّاً بن الحسين× عبّر عن المنبر بالأعواد، ولم يعدّه منبراً؛ لأنّ المنبر محلّ شرف لا يجلس عليه إلّا أولياء الله تعالى وعباده الصالحون، وليس أمثال معاوية وابنه يزيد ومرتزقتهما.
وقد ألحّ الحاضرون على يزيد بأن يسمح لعلي بن الحسين بالصعود على المنبر ليتكلّم بما يريد، لعلهم يسمعون منه شيئاً، إلّا أنّ يزيد ردّ عليهم بأنّه إذا صعد المنبر لن ينزل إلّا بفضيحته وفضيحة آل أبي سفيان([1236]). ولعلّ سبب رفض يزيد صعود الإمام المنبر معرفته بآل البيت، وما لديهم من قدرة في إقناع الآخرين بأسلوب خطابي ملئ بالاستدلال العقلي والمنطقي. إلّا أنّ الحضور قالوا ليزيد: «وما قدر ما يحسن هذا؟!»([1237])، ويبدو من هذا أنّ الحاضرين في مجلس يزيد استهانوا بعلي بن الحسين؛ لأنّهم يرونه هزيلاً ضعيفاً من شدّة المرض، ولأنّهم يجهلون قدر آل البيت لذا استخفوا بقدرته، فظنّوا أنّه غير قادر على قول شيء. فقال لهم يزيد: «إنّه من أهل بيت قد زقّوا العلم زقّاً»([1238])، ولم يزل الحضّار يلحّون على يزيد حتى أذِن لعلي بن الحسين بصعود المنبر، فلمّا صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه، ثمّ خطب خطبة أبكى فيها العيون، وأوجل فيها القلوب، وقد بيّن فيها للحاضرينحقيقة هؤلاء الذين ادّعى يزيد بأنّهم من الخوارج الذين خرجوا على إمام زمانهم([1239]).
تُعدّ خطبة علي بن الحسين÷ وثيقة تاريخية، كخطبة عمّته زينب بنت علي÷، حيث جمعت كثيراً من الحقائق والوقائع وقُدِّمت إلى أهل الشام، تلك الحقائق التي كانت غائبة عنهم؛ بسبب التضليل الإعلامي الأموي. وسرعان ما أثّرت تلك الخطبة في نفوس سامعيها، فغيّرت تلك الحقائق الأموية الجاثمة على عقولهم إلى حقائق مضيئة، أهمّها أنّ هؤلاء السبايا ليسوا من الخوارج كما يزعم الأمويون، بل إنّهم آل بيت النبوّة، الذين اعتدى عليهم يزيد بن معاوية وواليه في الكوفة عبيد الله بن زياد، فقتل الأعمّ الأغلب من الرجال والأطفال، ثمّ سبي ما تبقّى من النساء والأطفال.
وقد وجّه علي بن الحسين كلامه إلى النّاس الحاضرين في مجلس يزيد، معرّفاً بنفسه وبأهل بيته، بيت النبوّة، وما يحمل من صفات أخلاقية، وما قدّم للإسلام من تضحيّات، وما خصّهم الله تعالى من الفضل والعطايا التي ميّزتهم عن غيرهم من البشر.
فخاطب النّاس بأنّ الله تعالى أعطاهم ستّاً، منها العلم([1240])؛ أي العلم الرباني الذي لا يملكه أحد، وهو علم الكتاب، قال الرسول: «أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتِ الباب»([1241])، وقال الله تعالى: (وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا)([1242])، فمن أراد العلم فعليه بالباب([1243]). وفي رواية أخرى قال الرسول: «أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد العلم، فليقتبسه من علي»([1244]). وجاء عن علي بن أبي طالب× عندما كان في الكوفة، أنّه قال: «علّمني رسول الله ألف باب من العلم، يُفتح من كلّ باب ألف باب، خصّه به رسول الله من مكنون علمه ما خصّه الله به، فصار إلينا وتوارثناه من دون قومنا»([1245])، وعندما سُئِل أبو جعفر الباقر (ت114هـ/732م) عن قول علي بن أبي طالب: «سلوني عمّا شئتم، ولا تسألوني عن شيء إلّا أنبأتكم به»، قال: «إنّه ليس أحد عنده علم إلّا خرج من عند أمير المؤمنين، فليذهب النّاس حيث شاؤوا فوالله ليس الأمر إلّا من ههنا، وأشار بيده إلى بيته»([1246]). فالعلم الصحيح بعد الرسول’ الأكرم هو عند آل محمّد، فهم أهل بيته، ومَن كان من أهل البيت فهو أعلم بما في البيت، إذ قال الإمام محمّد الباقر: «ليذهبوا حيث شاؤوا أما والله لا تجدون العلم إلّا ههنا... عند آل محمّد»([1247]). وعن جعفر الصادق قال: «... لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أنّي أعلم، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأنّ موسى والخضر أعطيا علم ما كان، ولم يُعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله وراثة»([1248]). سأل هشام بن الحكم([1249]) الإمام الصادق وهما في موسم الحجّ، «قال هشام: إنّ علياً كان يدّعي علم الغيب، والله لم يطلع على غيبه أحداً، فمَن أين ادّعى ذلك؟ فقال الصادق: قال أبي ـ يعني الباقرـ: إنّ الله جلّ ذكره أنزل على نبيه كتاباً، بيّن فيه ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، إذ قال تعالى: (وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)([1250])»([1251]). وهذا هو العلم الذي منحه الله تعالى لآل البيت، الذي توارثوه عن الرسول، والذي كان يقصده علي بن الحسين (السجّاد)÷في خطبته.
وأُعطي أهل البيت الحِلم، وهي صفة تلازم العقلاء، وكذلك بمعنى الصبر، ولا يستفزّهم أحد من النّاس، ولا يغضبون على أحد إلّا لله تعالى.
كما أُعطي آل البيت السماحة: وهي الّلين في التعامل مع سائر البشر، والفصاحة: وهي البيان في حديثهم. قيل يا رسول الله، ما رأينا أفصح منك، قال: «وما يمنعني وأنا أفصح العرب، وأنزل الله القرآن بلغتي، وهي أفضل اللغات»([1252])، فما كان أحد يجاريه في البلاغة، وهو القائل: «انا افصح من نطق بالضاد، بيد أنّي من قريش، واسترضعت في بني سعد»([1253])، نطق بهذه الكلمة الجامعة، وعلى الرغم من أنّ أعداءه كانوا يتربّصون به لنقض قوله، فلم يجدوا عليه نقصاً في كلمة شاذّة لهج بها، أو لحن أو جملة ركيكة.
وأُعطوا الشجاعة، وكل العرب يشهد بشجاعة بني هاشم، ويكفي مثلاً على ذلك صولات وجولات علي بن أبي طالب× في كلّ معارك الإسلام، سواء أكان ذلك في عهد الرسول’ أم بعده، فضلاً عن شجاعة الحسين بن علي يوم الطفّ، وأخوته وبني عمومته، فلم يستكينوا للذلّ والهوان، بل فضّلوا الشهادة على ذلك في سبيل الله تعالى.
وأُعطوا المحبّة في قلوب النّاس، أي ميل النفوس إليهم، وإن المحبّة لا تأتي إلّا من عند الله، فهو الذي يزرع هذه المحبّة الخاصّة، وهي محبّة المؤمنين لآل البيت.
وفضّل الله تعالى آل البيت^ ـ وفقاً لقول علي بن الحسين÷ ـ بسبع، منها: أنّ منهم النبي ٍالمختار محمّد، الذي كان رحمة للعالمين، ومنقذاً لهم من الشرك والوثنية،ومن الطبيعي أن هذا أمر لا ينكره أحد من المسلمين؛ لأنّ الرسول’ الأكرم من البيت الهاشمي من قريش، وهذا ما كان يتباهى به العرب، وكانوا يحاولون إدخال بعضهم مع قريش؛ لأنّهم أشرف العرب، وآل محمّد أشرف بيت في قريش.
وكذا منهم الصدّيق، وهو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×؛ لقوله: «أنا الصدّيق الأكبر، والفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام أبي بكر، وصلّيت قبل صلاته»([1254])، وقال أيضا: «أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصدّيق الأكبر، لا يقولها بعدي إلّا كذّاب، صلّيت قبل النّاس بسبع سنين»([1255]).
ومنهم الطيّار، وهو جعفر بن أبي طالب، الذي قُطِعت يداه واستُشهِد في معركة مؤتة سنة 8هـ/629م([1256])، فقال رسول الله’ في حقّه: «لقد أبدله الله بهما جناحين، يطير بهما في الجنّة»([1257]).
ومنهم أسد الله وأسد الرسول’، وهو حمزة بن عبد المطّلب، فقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله: «ما في القيامة راكب غيرنا نحن أربعة، فقال له عمّه العباس: ومَن هم يا رسول الله؟...... قال: وعمّي حمزة أسد الله وأسد رسوله سيّد الشهداء، على ناقتي العضباء»([1258]).
ومنهم سيّدة نساء العالمين، فاطمة البتول‘، وهي بنت الرسول محمّد|، وزوجة الوصي علي بن أبي طالب، وأمّ السبطين الحسن والحسين، وكانت منقطعة إلى الله تعالى.
ومنهم سبطا هذه الأمّة، وسيّدا شباب أهل الجنّة، فقد قال الرسول’: «الحسن والحسين سبطا هذه الأمّة»([1259]).
وممّا تقدّم وضّح الإمام علي بن الحسين÷ للجالسين في مجلس يزيد أنّ الذين أمامهم من السبايا هم عائلة الحسين بن علي، ابن الرسالة المحمّدية، ويمتلك أهله كلّ العطايا الحميدة، وكلّ الفضل الذي خصّهم به الله تعالى دون غيرهم، وبالتالي فهل يحقّ ليزيد أن يقتل رجالهم، ويسبي نساءهم وأطفالهم؟!
ثمّ انتقل علي بن الحسين÷إلى التعريف بنسبه الشريف، حيث قال: «فمَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني أنبأته بحسبي([1260])ونسبي([1261])، أنا ابن مكّة([1262])ومِنى([1263])، أنا ابن زمزم([1264])والصفا([1265])، أنا ابن مَن حمل الركن بأطراف الرداء([1266])، أنا ابن خير مَن ائتزر وارتدى، أنا ابن خير مَن انتعل واحتفى، أنا ابن خير مَن طاف([1267])وسعى([1268])، أنا ابن خير مَن حجّ ولبّى([1269])، أنا ابن مَن حُمل على البراق([1270])في الهواء، أنا ابن مَن أُسريَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى([1271])، فسبحان مَن أسرى، أنا ابن مَن بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن مَن دَنَا فتدلّى فكان من ربّه قاب قوسينِ أو أدنى، أنا ابن مَن صلّى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمّد المصطفى([1272])، أنا ابن علي المرتضى([1273]) أنا ابن من ضرب خراطيم([1274])الخلق حتى قالوا لا اله إلّا الله».
لقد أشار الإمام زين العابدين× إلى أنّه ابن تلك الأماكن المقدّسة عند المسلمين، مثل مكّة ومِنى، وزمزم والصفا، وأنّه ابن ذلك الرجل الذي حلّ مشكلة القبائل العربية في مكّة، وذلك عند خلافها حول وضع الحجر الأسود في مكانه أثناء إعادتهم بناء الكعبة، وهذه إشارة إلى جدّه النبي محمّد عندما وضع الحجر وسط الرداء، ثمّ أمر القبائل أن تشترك في رفعه، وبعدها أخذه بيده ووضعه في مكانه، ثمّ أتمّ البناء عليه([1275])، واستمر في تعداد المناقب الحسنة لأهل بيته من أجداده، ولاسيما في أدائهم العبادات كالصلاة والحجّ ومناسكه، والسعي ماشياً ومهروّلاً بين الصفا والمروة، وفي كلّ هذه الأحوال لا يوجد أفضل من الرسول’ وأهل بيته، صدقاً في الإيمان، وإخلاصاً في الأداء.
ومن باب التعريف بنفسه وصِلته بالرسول؛ ذكر الإمام علي بن الحسين÷ لحضّار مجلس يزيد حادثة الإسراء والمعراج، إذ أُسري بجدّه النبي محمّد| من المسجد الحرام في مكّة إلى المسجد الأقصى في القدس، ولم تصل إلى هذه المرتبة بقيّة الأنبياء، حيث بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، وهي موجودة في السماء السابعة، ولا يتجاوزها ملك ولا نبي، وإن جدّه النبي قد دَنَا من ربّه ربّ السموات والأرض، وصلّى بملائكة السماء، وأوحى إليه الله تعالى ما أوحى. وبعد هذه المناقب والمفاخر ومكانته الرفيعة صرّح الإمام علي بن الحسين÷ علناً، أنّه ابن محمّد المصطفى، وبهذا حرّك قلوب الحضور تجاهه.
ثمّ انتقل الإمام علي بن الحسين÷ إلى التعريف، بذكر جدّه المرتضى علي بن أبي طالب، الذي اتّبعت السلطة الأموية سياسة سبّه وشتمه؛ لتحقيق أهدافها، ذلك الذي ضرب أنوف النّاس حتى قالوا لا اله إلّا الله، وهذه إشارة واضحة إلى دور علي بن أبي طالب في نشر الإسلام.
وقال علي بن الحسين÷: «أنا ابن من ضرب بين يدَي رسول الله بسيفينِ، وطعن برمحينِ»، وهذه إشارة إلى قول علي بن أبي طالب÷: «انا الضارب بالسيفينِ»([1276])، وهناك عدّة تفسيرات لهذا النصّ، منها: إنّه حارب بسيف التنزيل في حياة الرسول’ وبسيف التأويل بعده([1277]). وقيل: إنّ الإمام علياً قاتل بسيفين في بعض المعارك، حيث إنّ النبي قد أعطاه السيف المسمّى بذي الفقار ذا الشعبتين([1278])، بعد أن انكسر سيفه الذي بيده([1279]).«وهاجر الهجرتينِ»([1280])، وهذه إشارة إلى هجرة المسلمين إلى الحبشة، إلّا أنّه لم يثبت أنّ علياً قد هاجر إليها مع المسلمين([1281])، والهجرة إلى يثرب، وقد هاجر إليها علي، ولعلّ الهجرة الثانية لعلي مع النبي إلى الطائف مع أنّها أيّام معدودة([1282]).
«وبايع البيعتينِ([1283])، وصلى القبلتينِ»([1284])، كانت أول بيعة هي بيعة المسلمين للنبي’ في بدر عام 2هـ/623م، على أن يقاتلوا معه ولا يتخلّون عنه([1285]). والبيعة الثانية هي بيعة الرضوان عام 6هـ/627م، والتي بايع فيها المسلمون الرسول’ تحت الشجرة([1286]).
وأمّا بالنسبة إلى الصلاة إلى القبلتينِ، لقد فرضت الصلاة على المسلمين قبل الهجرة بعام، وكانت قبلتهم نحو المسجد الأقصى في بيت المقدس([1287])، ثمّ حُوِّلت القبلة نحو المسجد الحرام في مكّة، بعد أن نزل قوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ) ([1288])، وكان ذلك في العام الثاني للهجرة، وقد صلى علي بن أبي طالب لهاتينِ القبلتين([1289]).
«وقاتل ببدر وحنين»، لقد كان لعلي× دور مهمّ في هاتين المعركتين، أمّا بالنسبة لمعركة بدر فقد حدثت عام 2هـ/623م، وانتصر فيها المسلمون نصراً ساحقاً على مشركي قريش، إذ حطّمت رؤوس الكفر. ومعركة حنين وقعت بين المسلمين والمشركين في عام 8هـ/629م، وانتصر فيها المسلمون أيضا([1290])، وإنّ ذكر معركتي بدر وحنين من قِبَل الإمام السجّاد×، ودور جدّه علي بن أبي طالب فيهما؛ لخصوصيتهما، إذ إنّ معركة بدر هي أول المعارك التي خاضها المسلمون ضد المشركين، ومعركة حنين نظراً لما واجهه المسلمون فيها من صعوبات([1291]).
«ولم يكفر بالله طرفة عين»، قد جاء عن الرسول: «ثلاثة ما كفروا بالله قطّ، مؤمن آل ياسين، وعلي بن أبي طالب، وآسيا امرأة فرعون»([1292]).
«أنا ابن
صالح المؤمنين»، لقد ذكر
عبد الله بن عباس حديثا عن الرسول’:
«...
معاشر النّاس إنّ علياً باب الهدى بعدي، الداعي إلى ربّي، وهو صالح المؤمنين،
ووارث النبيّين»([1293])، وأشار
الرسول’ في قول آخر: «ولقد أعلَمني
ربّي تبارك وتعالى أنّه سيّد المسلمين، وإمام
المتّقين، وأمير المؤمنين، ووارثي ووارث النبيين([1294])، وقامع([1295])الملحدين([1296])،ويعسوب([1297])المسلمين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتاج([1298])البكّائين، وأصبر الصابرين، وأفضل القائمين من آل ياسين، ورسول ربّ
العالمين». عدّد
الإمام علي بن الحسين÷ عدّة صفات لجدّه علي×، فهو الذي
أذلّ الذين ألحدوا بدين الله تعالى، وكذّبوا بما جاء به رسوله من العرب واليهود.
ويعسوب المسلمين، أي رئيسهم؛ لأنّ اليعسوب هو أمير النحل، وقد استعمل هذا اللفظ
هنا مجازاً. وهو نور وضياء للذين يجاهدون معه في ساحات الوغى، لنشر الإسلام، أو
دحض أعدائه. وفي عبادته فهو أفضل المسلمين بعد الرسول، في قيامه وصيامه وجهاده، وأمره
بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقضاء حوائج النّاس، وهو مع كلّ هذا كان كثير البكاء من
خشية الله تعالى، بل هو ملك البُكاة وسيّدهم، وكان جبلاً أشمّ في تحمّله الصعاب،
ومن ثمّ التغلّب عليها.
ويواصل الإمام علي بن الحسين÷، ذكر مناقب جدّه علي بن أبي طالب÷ بقوله: «أنا ابن المؤيّد بجبرائيل، والمنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حُرم المسلمين، وقاتل الناكثين([1299])والقاسطين([1300])والمارقين([1301])، والمجاهد أعداءه الناصبين»([1302])، وهنا نجد أنّ علياً× يحظى بتأييد ملائكة السماء ونصرهم له، وهو صاحب غيرة على حُرمات المسلمين، فهو حامٍ لها بكل ما يملك من غالٍ ونفيس، وهو عدوٌ لدود لِمَن ينقض العهود، ومَن مال عن جادّة الحقّ والصواب، والمتلوّنين في مواقفهم التي لا تُوحي إلى الموقف الإسلامي الصحيح. وجاهد في قتاله كلّ من جعل العداوة نصب عينيه لآل البيت، وهذا ما حدث في معارك الجمل وصفين والنهروان.
«وأفخر مَن مشى من قريش أجمعين، وأول مَن أجاب واستجاب لله من المؤمنين، وأقدم السابقين، وقاصم([1303]) المعتدين، ومُبير([1304]) المشركين، وسهم من مرامي الله على المنافقين»([1305])، ومن فضائل الإمام علي بن أبي طالب أنّه لا توجد شائبة في نسبه الشريف، وقد وُلِد في الكعبة الشريفة دون الخلق كلّه، واتصاله بالرسول منذ ولادته إلى وفاته في حِلّه وترحاله إلّا ما ندر، وزوج ابنته والتي هي قطعة من الرسول’ ذاته، وهو أوّل من صدّق بدين الله تعالى الذي أُنزِل على النبي محمّد’، وله السبق في ذلك([1306])، وهو للمعتدين والمشركين والمنافقين مشتّت ومفرِّق لهم، وسهم من الله تعالى عليهم.
«ولسان كلمة العابدين، ناصر دين الله، ووليّ أمر الله، وبستان حكمة الله، وعَيبة([1307])علم الله»، أي تجد عند علي من الحكمة التي سخّرت لنصرة الدين، وأنّه مستودع لعلم الله تعالى، وبهذا فهو وليّ المسلمين.
«سَمِح([1308])سخي([1309])، بهلول([1310])، زكي([1311])، أبطحي([1312])، رضيمرضي([1313])،
مقدام([1314])همام([1315])، صابرصوّام، مهذّبقوّام، شجاعقمقام([1316])»، وهنا ذكر الإمام علي بن الحسين÷ عددا من الخصال التي اتّصف بها جدّه
الإمام علي× الجامع لكلّ خير، ومنها أنّه كثير السماحة والكرم والجود مع النّاس،
ضحّاك في الحروب لا يبالي بها، متقدّم صفوف الجيوش، ذو شجاعة وهمّة عظيمة، سهل
ليّن في مجلسه، طاهر من الصفات الذميمة، خليٌّ من العيوب، حابس نفسه عن إظهار
الجزع، راضٍ بما قسم الله تعالى له، واللهراضٍ عنه، كثير الصيام والقيام، واسع الفضل والإحسان.
«قاطع الأصلاب([1317])، ومفرّق الأحزاب، أربطهم جَناناً([1318])، وأطلقهم عناناً، وأجرأهم لساناً([1319])، وأمضاهم عزيمة([1320])، وأشدّهم شكيمة([1321])»، بيّن الإمام السجّاد× أنّ علياً× قاطع لأصلاب الكافرين، أي ذريّتهم الكافرة، وذلك بانتصاره في الحروب على أعدائه. وقد فرّق الجيش الذي حاصر المدينة المنوّرة، وذلك في الغزوة التي سُمّيت بغزوة الأحزاب أو الخندق في عام 5هـ/626م، وقتل أشجع قاداتهم عمرو بن ودّ العامري([1322])، وبقتله تفرّقت الأحزاب المهاجمة للمدينة المنوّرة([1323]). وأنّه لا يفزع، بل كان مستقرّ القلب، مهاجماً جريئاً جسوراً، حازماً ما عقد قلبه على فعله، لا تأخذه لومة لائم في قول الحقّ، وذلك من خشيته من الله تعالى، وهذا هو طبعه في كلّ الأحوال.
«أسد باسل([1324])، وغيث هاطل([1325])، يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت([1326]) الأسنّة([1327]) وقربت الأعنّة([1328]) طحن الرحى، ويذروهم ذرو الريح الهشيم([1329])، ليث([1330]) الحجاز([1331])»،أي أسد عبوس في الشجاعة، وسيف قاطع على أعدائه إذا ما اجتمعت رماحهم واشتبكت، فيكون تأثيره تأثير المطر الشديد، يطحن أعداءه طحن الدقيق وإن كان صلباً، وينثره كنثر اليابس من أوراق الأشجار في الهواء.
«وصاحب الأعجاز([1332])، وكبش([1333])العراق، الإمام بالنصّ والاستحقاق»، أي أنّ علياً× في كلامه وأفعاله معجزات، لا يتمكّن أحد أن يأتي بها، فهو سيّد العراق، وقد تمّ تعيينه إماماً من قبل الله تعالى ورسوله، قال الله تعالى: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)([1334])، وقال النبي’: «إنّ الله مولاي، وأنا مولى المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمَن كنت مولاه فعلي مولاه ـ قالها ثلاث مرات، وقيل أربع([1335])ـ اللهم والِ مَن والاه، وعادِ مَن عاداه، وأحبّ مَن أحبّه، وابغض مَن أبغضه، وانصر مَن نصره، واخذل مَن خذله، وأدر الحقّ معه حيث دار، ألا فليبلّغ الشاهدُ الغائبَ»([1336]).
وأمّا في استحقاقه فلديه من الإمكانات والقدرات والخبرات التي تؤهّله لإمامة أمّة محمّد’، وخليفة لدولتها، وإدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. روى أبو سعيد الخدري: أنّه كان مع النبي في مكّة إذ ورد عليه أعرابي، فسأل النبي قائلاً: «اين علي بن أبي طالب من قلبك؟ فأجاب النبي: يا أعرابي، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، وسطح الأرض على وجه الماء، لقد سألتني عن سيّد كلّ أبيض وأسود، وأول من صام وزكّى وتصدّق، وصلّى القبلتينِ، وبايع البيعتينِ، وهاجر الهجرتينِ، وحمل الرايتينِ، وفتح بدراً وحنين، ثمّ لم يعصِ الله طرفة عين، فغاب الأعرابي من بين يدي رسول الله’، وهو جبرائيل»([1337]).
«مكيّ مدنيّ، أبطحي تهامي([1338])، خيفي([1339])عقبي، بدري أُحدي، شجري مهاجري»، وهذه مواضع في الحجاز، نُسِب علي بن أبي طالب إليها، لأنّه ابن الجزيرة العربية، ثمّ نُسِب إلى معركتي بدر وأحد؛ لصولاته وجولاته فيهما، فضلاً عن بيعته، بيعة الرضوان، وهجرته.
«من العرب سيّدها، ومن الوغى ليثها([1340])، وارث المشعرينِ([1341])، وأبو السبطينِ الحسن والحسين، مظهر العجائب، ومفرّق الكتائب([1342])، والشهاب([1343])الثاقب([1344])، والنور العاقب([1345])، أسد الله الغالب([1346])، مطلوب كلّ طالب([1347])، غالب كلّ غالب، ذاك جدّي علي بن أبي طالب»، إنّ علياً سيّد العرب؛ لصفاته التي يتميّز بها عن الآخرين، فهو في الحروب الأسد الضرغام، ومفرّق الجيوش على ضخامتها، ويتهاوى أمامه غالبو الرجال، وقد ورث مشاعر الحجّ ومناسكه في البيت الحرام، وهو أبو ولدَي بنت النبي’ الحسن والحسين، سيدَي شباب أهل الجنّة، وهو شعلة تضيء كلّ مكان، وشعاع يُهتدى به يمثّل آخر الأوصياء، وهو يغلب أقرانه، ويشفع لِمَن يطلب شفاعته، هذا هو جدّ الإمام علي بن الحسين، علي بن أبي طالب^، وهذه صفاته ومواقفه في الإسلام، ولا يوجد شخص أفضل منه في عصره أو العصور التي تلت عهده، باستثناء النبي محمّد’.
وبعد أن عرّف الإمام علي بن الحسين÷بجَدَّيه النبي محمّد بن عبد الله والوصي علي بن أبي طالب، انتقل إلى التعريف بنفسه قائلاً: «أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيّدة نساء العالمين، أنا ابن الطُهر البتول، أنا ابن بضعة([1348])الرسول»، ولم يزل يقول أنا أنا حتى ضجّ النّاس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد من الفتنة، فقطع خطبة الإمام علي بن الحسين÷ بالأذان.
ولم ينجح يزيد بأمره المؤذّن بالأذان بمنع الإمام من مواصلة كلامه واستدلالاته، بل فضحه الإمام علي بن الحسين÷ في كلّ مقطع من الأذان، إذ يسأله ولم يجب يزيد على سؤاله، ممّا سبّب له إحراجاً أمام المجلس بعد أن كشفت حقائق الأحداث، وبطلان الزيف والتضليل الأمويين.
قالوا: ولايزال علي بن الحسين÷ وهو في خطبته يقول: «أنا، أنا، حتى ضجّ النّاس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد أن تكون فتنة، فأمر المؤذِّن أن يُؤذِّن فقطع عليه الكلام وسكت، فلمّا قال المؤذّن: الله أكبر، قال علي بن الحسين÷: كبّرت كبيراً لا يُقاس ولا يُدرك بالحواس، لا شيء أكبر من الله. فلمّا قال: أشهد أن لا إله إلّا الله، قال علي بن الحسين ÷: شَهِد بها شعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعظمي. فلمّا قال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله|، التفت× من أعلى المنبر إلى يزيد وقال: يا يزيد، محمّد هذا جدّي أم جدّك؟! فإن زعمتَ أنّه جدّك فقد كذبتَ، وإن قلتَ أنّه جدّي فِلَم قتلتَ عترته؟! قال: وفرغ المؤذِّن من الأذان والإقامة، فتقدّم يزيد وصلى صلاة الظهر»([1349]). بينما يروي أبو مخنف، أنّ يزيد لم يُصلّ بعد نهاية الأذان والإقامة، بل ترك المجلس ودخل بيته، ولم يردّ على علي بن الحسين÷([1350]).
لقد تمكّن الإمام السجّاد× في خطبته أن يزيل كلّ التضليل والدعايات الإعلامية الأموية، التي روّجتها السياسة الأموية، والتي ركّزت على أنّ هؤلاء الأسرى من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة يزيد بن معاوية، فبدّلت نشوة الإنتصار عند يزيد وأتباعه إلى هزيمة وانكسار، وفرحهم إلى حزن وبكاء.
إنّ المتأمّل في كلمات خطبة الإمام علي بن الحسين÷ لا بدّ أن يتبادر إلى ذهنه الحكمة أو السبب الذي جعل الإمام× يلتزم ـ وفي جميع فقراتها ـ بذكر هويّته الشخصية فقط، فإنّ الأسلوب الذي اتّبعه الإمام× في خطبته ينمّ عن حكمة وتدبير سياسي واعٍ؛ إذ إنّ الإعلان عن إسمه قضية شخصية، ومن أبسط الحقوق التي تُمنح للفرد وإن كان في حالة الأسر، بينما لو كان قد تطرّق إلى شيء من مساوئ الأمويين وفضائحهم لَمنِع من الكلام والنطق. لقد كان كلام الإمام علي بن الحسين÷ مليئاً بالتذكير والتعريف بشخصيته ونسبه الشريف، وعلاقته وصلته بالإسلام وبرسوله، لذلك ابتدأ كلامه بما منحه الله تعالى لهم من صفات اختصّهم بها، لينتقل بعدها للتعريف برسول الله’، وذكر أهمّ الأحداث التي جرت منذ بدء الدعوة الإسلامية،ثمّ بعد ذلك التعريف بجدّه علي بن أبي طالب، وأهم المواقف والوقائع التي شارك فيها، لينتقل بعد ذلك للتعريف ببضعة الرسول’ ومكانتها عند رسول الله وأهل بيته، وبعد هذه المقدّمة بيّن للحاضرين الكيفية التي قُتِل فيها الحسين.
كما نلاحظ أنّه ركّز في خطبته على ذكر المواقع الجغرافية في مكّة والمدينة المنوّرة، والمواقف والأحداث الحاسمة التي جرت فيها، وربط نفسه بكلّ ذلك بما فيه من قدسية، ومع هذا فهو يقف كأسير أمام أهل المجلس.
وقد فهم النّاس ذلك بعمق، كما فهموا بأنّ الحكّام الأمويين الذين حصلوا على مواقع السلطة والخلافة من خلال ربط أنفسهم بالإسلام، وإذا بهم عملوا ما عملوا بأبناء الرسالة وأهل بيت النبوّة، لدرجة أن يُؤتى بهم سبايا وأسرى بيد السلطة التي تحكم باسم الإسلام؛ لذلك ضجّ النّاس بالبكاء. كما فَهمَ كلّ من في المجلس أنّ جهل أهل الشام بأهل البيت ـ مضافاً إلى حقد الحكّام على أهل البيت عامّة، وعلى الذين كانوا مع الحسين في كربلاء خاصّة ـ كان له الأثر الكبير في وصول الأمر إلى هذه الحالة.
ولم يغب عن ذهن الإمام علي بن الحسين÷ أخذ الحيطة والحذر من أن يحسّ يزيد بأنّ هؤلاء الأسرى يشكّلون خطراً عليه، فيعمل على التخلّص منهم وإبادتهم؛ لذا فإنّ ما قام به الإمام السجّاد× من حصر خطبته بإطار شخصي منع من إثارة غضبه وحقده.
لقد تمكّن الإمام علي بن الحسين÷ من استغلال الفرصة التي أُتِيحت له، فعمل على التنويه بشخصيته وبقضيته وبهمومه، ولو بالكناية التي كانت أبلغ من التصريح،فلذلك لم يذكر شيئا من فضائح الأمويين، ولم يتعرّض لمساوئهم، على الرغم من توقّع يزيد لهذا الأمر، بقوله: «لم ينزل إلّا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان»، وبذلك نجا من القتل ومن أن يُمنع من الكلام، واستمرّ في نشر الأهداف التي من أجلها قُتل الحسين بن علي÷ وأصحابه من الشهداء.
وبعد أن انتهى يزيد بن معاوية من مراسيم الاحتفال الذي أُقيم في قصره، خشى من ازدياد الرفض وانقلاب النّاس عليه، فأمر بحبس سبايا آل البيت^ من النساء والصبيان في بيت خرب واهي الجدران([1351])، لا يقيهم من برد أو حرّ([1352])، فقال بعض السبايا: «إنّما جعلنا في هذا البيت ليقع علينا، فقال الموكّلون بهم من الحرس بالقبطية([1353]): انظروا إلى هؤلاء يخافون أن يقع عليهم هذا البيت، وهو أصلح لهم من أن يُخرَجوا غداً فتُضرَب أعناقهم واحداً بعد واحد صبراً، فقال علي بن الحسين بالقبطية: لا يكونان جميعاً بإذن الله، وكان كما قال علي بن الحسين»([1354]).
لقد كان الموضع الذي أُودِعوا فيه سبايا آل البيت لا يقيهم من الحرّ، حتى تقشّرت وجوههم([1355]).
ويُلاحظ على هذه الرواية أنّها أشارت إلى ارتفاع حرارة الشمس التي أدّت إلى تقشّر وجوه سبايا آل البيت، ولكنّ جوّ بلاد الشام في شهر تشرين الثاني([1356])ـ وهو الوقت الذي وصلت فيه قافلة السبايا ـ يكون بارداً أو معتدلاً؛ وعليه ربما يكون معنى أنّ تقشّر الوجوه إنّما هو بسبب انخفاض درجة الحرارة لا ارتفاعها، ولم يكن هذا السبب الوحيد لتقشّر وجوه السبايا، بل التعب الثقيل الذي عانوا منه، لسيرهم في طريق طويل خلال سبيهم من الطفّ إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، وإزاء هذا لم تتقشّر وجوههم فحسب بل تغيّرت ألوانهم.
خرج الإمام علي بن الحسين÷ ذات يوم من الأيّام التي احتُجِزوا فيها يتمشّى في أسواق دمشق، لأنّه ملّ من الجلوس وعدم الحركة، فتلقّاه المنهال بن عمرو([1357])، أو دخل عليه في سجنه، فسأله عن حاله قائلاً: كيف أصبحتَ أو أمسيتَ يا ابن رسول الله؟ فأجابه قائلاً: «كحال مَن أصبحوا وقد فقدوا الستر والغطاء، وقد أُعدِموا الكفيل والحمى، فهل تراني إلّا أسيراً ذليلاً قد أُعدِم الناصر والكفيل، قد كُسِيتُ أنا وأهل بيتي ثياب الأسى([1358])، وقد حُرِّم علينا جديد العرى([1359])، فإن تسأل فها أنا كما ترى، قد شمتت بنا الأعداء، ونترقّب الموت صباحاً ومساءً، ثمّ قال:... ونحن أهل بيته أصبحنا مقتولين، قد حلّت بنا الرزايا، نُساق سبايا، ونُجلب هدايا، كأن حسبنا من اسقاط الحسب، ومنتسبنا من أرذل النسب، كأن لم نكن على هام المجد رقينا، وعلى بساط الجليل سعينا، وأصبح الملك ليزيد وجنوده، وأضحت بنو المصطفى من أدنى عبيده([1360])،... ما كنت أرى شيخاً ـ أي المنهال ـ من أهل المصر مثلك لا يدري كيف أصبحنا، أمّا إذ لم تدرِِ أو تعلم فسأخبرك، أصبحنا في قومنا بمنزلة بني اسرائيل في آل فرعون، إذ كانوا يذبّحون أبناءهم، ويستحيون([1361])نساءهم، وأصبح شيخنا وسيّدنا يُتقرَّب إلى عدونا بشتمه أو سبّه على المنابر، وأصبحت قريش تُعدّ أنّ لها الفضل على العرب لأنّ محمّداً منها لا يُعدّ لها فضل إلّا به، وأصبحت العرب مقرّة لهم بذلك، وتُعدّ أنّ لها الفضل على العجم لأنّ محمّداً منها لا يُعدّ لها فضل إلّا به، وأصبحت العجم مقرّة لهم بذلك، فلئن كانت العرب صدقت أنّ لها الفضل على العجم، وصدقت قريش أنّ لها الفضل على العرب؛ لأنّ محمّداً منها، أي أنّ لنا أهل البيت الفضل على قريش؛ لأنّ محمّداً منّا، فأصبحوا يأخذون بحقّنا ولا يعرفون لنا حقّاً، هكذا أصبحنا إذا لم تعلم كيف أصبحنا...([1362])،... وأمسينا بيت محمّد ونحن مغصوبون مظلومون مقهورون مقتلون مثبورون([1363])مطرودون، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون على ما أمسينا فيه يا منهال»([1364]).
وممّا تقدّم يبدو أنّ السجن الذي أُودِعوا فيه سبايا آل البيت لم يتّصف بالصرامة والشدّة، بحيث لا يُسمح لهم بالخروج أو دخول النّاس عليهم، مع إحاطته بالحرس الموكّل على حراسته، وهم من غير المسلمين، بل من الأقباط النصارى.
واختلفت الروايات في لقاء الإمام علي بن الحسين÷ مع المنهال بن عمرو، وهو من محبّي أهل البيت، هل كان خارج السجن أو داخله؟ صباحاً كان أو مساءً؟
وعلى أيّ حال، فإنّ جواب علي بن الحسين÷، على أسئلة المنهال كان صورةً واضحةً بيّنت حال سبايا آل البيت، فبينما كانت العرب تتفاضل على العجم بأنّ محمّداً منها، وتقرّ العجم لهم بذلك، وتتفاضل قريش على العرب بأنّ محمّداً منها، وتقرّ العرب لهم بذلك، ويتفاضل أهل البيت على الجميع بأنّ محمّداً منهم، بل جدّهم، ويُقرّ لهم بذلك، لكنّهم لم يقرّوا لهم بحقّهم! فأصبح آل البيت بين المسلمين كبني إسرائيل في قوم فرعون، يقتلون الرجال ويتركون النساء. ولم يكتفوا بشتم وسبّ جدّهم علي على المنابر، بل تعدّوا إلى أبعد من ذلك، فقتلوا ذريته، ذريّة النبوّة وسبطها، ثمّ ساقوا ما تبقّى منهم أسارى وسبايا من الكوفة إلى دمشق، إلى ابن الطلقاء يزيد بن معاوية، كأنّهم لا حسب شريف ولا قرابة نبوية مقدسة لهم. ومن هوان الدنيا أن يكون الملك ليزيد وأعوانه، وبنو المصطفى كالعبيد يُقادون من موضع إلى آخر تحت شماتة أعدائهم، إذ فقدوا الكفلاء والحماة والناصرين، وغُصِبت حقوقهم، وعاشوا تحت الظلم والقهر والقتل، وإزاء كلّ هذه المصائب نرى آل البيت أشدّاء أقوياء، رجالاً ونساءاً، متمسّكين بالله تعالى وقوّته ورحمته، فهو الحكم وإليه تُرجع الأمور.
أصداء الرفض لفعل يزيد بن معاوية
لقد أدّت الجرائم التي ارتكبها يزيد بن معاوية بحقّ آل البيت^ إلى سخط المسلمين وغيرهم، والذي أجّج هذا السخط بشكل أشدّ عند الناس تلك الخطب التي ألقاه الإمام علي بن الحسين÷ وعمّته السيّدة زينب بنت علي÷ في مجلس يزيد من جهة، والحالة المأساوية التي عاشها سبايا آل البيت’ ـ وقد شاهدها النّاس عند استعراضهم في شوارع دمشق وأسواقها ـ من جهة أخرى. وقد سارت الأحداث على عكس ما كان يهدف إليه يزيد، حيث أراد أن يخلق جواً مضادّاً لثورة الحسين×، إلّا أنّ ما حدث هو ازدياد النقمة عليه وعلى ما قام به، حتى في الأوساط الأموية التي كانت حاضرة في مجلسه، وممّا يؤكّد ذلك ما قام به عدد من الحاضرين في مجلس يزيد بن معاوية، منهم:
1 ـ الصحابي أبو برزة الأسلمي([1365]):
عندما سمع أبو برزة الأسلمي يزيد يُردّد أبيات الحصين بن الحمام المرّي، وهو ينكت بمخصرته ثنايا أبي عبد الله الحسين؛ أثاره هذا الموقف، وانتفض بوجه يزيد المتهوّر دون التفكير بالنتائج المحتملة التي قد تصدر عنه، قائلاً له: «أتنكت بقضيبك ثنايا الحسين وثغره؟! أشهد لقد رأيت رسول الله يرشف ثناياه وثنايا أخيه، ثمّ إنّك يا يزيد تجئ يوم القيامة وابن زياد شفيعك، ويجئ هذا ـ واشار إلى رأس الحسين ـ ومحمّد شفيعه»([1366])، فأغضبه قول أبي برزة وأمر بإخراجه من المجلس، فأخرجوه سحباً([1367]). ويُعدّ موقف أبي برزة هذا ـ الذي كان مشابهاً لموقف زيد بن الأرقم في مجلس ابن زياد في الكوفة ـ بداية لردود الأفعال على يزيد.
2 ـ عبد الرحمن بن الحكم([1368]) أو يحيى بن الحكم:
أشار أبو مخنف إلى أنّ الأمراء المصاحبين لقافلة سبايا آل البيت لمّا قدموا برأس الحسين ودخلوا مسجد دمشق، سألهم مروان بن الحكم عمّا فعلوه بآل البيت، فأجابوه بأنّه قدم عليهم بثمانية عشر رجلاً فقتلناهم جميعاً، وهذه رؤوس القتلى، وسبينا ما تبقّى من عيال الحسين، ولم يرق هذا لمروان فانصرف عنهم وتركهم، وبعده سألهم أخوه يحيى بن الحكم، فأجابوه بما أجابوا أخاه مروان، فقال يحيى: «حُجبتم عن محمّد يوم القيامة، لن أجامعكم على أمر أبداً»([1369]).
أمّا أبو الفرج الأصفهاني فقد أشار إلى أنّ عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاصي هو الذي كان حاضراً عند يزيد بن معاوية، عندما بعث إليه عبيدالله بن زياد برأس الحسين بن عليّ، فلما وُضِع بين يدي يزيد في الطَّشت بكى عبد الرحمن، ثمّ قال:
|
أبلغ أمير المؤمنين فلا تكن |
فصاح به يزيد: أسكت يا ابن الحمقاء، وما أنت وهذا؟ ([1370]).
3 ـ مؤذّن الجامع الأموي:
عندما علت الأصوات من كلّ جانب في المجلس بعد خطبة علي بن الحسين (السجّاد)÷، قال يزيد للذي أصعدَ علي بن الحسين المنبر: «ويحك أردت بصعوده زوال ملكي، فقال والله ما علمت أنّ هذا الغلام يتكلّم بمثل هذا الكلام. فقال يزيد له: ماعلمت أنّ هذا من أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة، فقال المؤذّن له: إذا كان كذلك فلمَ قتلت أباه، فأمر يزيد بضرب عنقه»([1371]).
4 ـ واثلة بن الأسقع:
من الذين أبدوا غضبهم واستياءهم على يزيد بن معاوية لما فعله بالحسين بن علي وأهل بيته واثلة بن الأسقع، الذي غضب عندما رأى رجلاً من أهل الشام مسروراً فَرِحاً بقتل الحسين وسبي عياله، فقال: «والله لا أزال أحبّ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً أبداً، بعد إذ سمعت رسول الله في منزل أمّ سلمة، وجاء الحسن فأجلسه على فخذه اليمنى وقبّله، وجاء الحسين فأجلسه على فخذه اليسرى وقبّله، ثمّ جاءت فاطمة فأجلسها بين يديه، ثمّ دعا بعلي فجاء فجلس بين يديه، ثمّ أردف عليهم كساء خيبرياً، كأنّي أنظر إليه، ثمّ قال (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([1372])»([1373]).
5 ـ رسول قيصر النصراني
إنّ رسالة الثورة الحسينية لم تنحصر بطائفة دون أخرى، ولا بقوم دون آخرين، ولا بزمان دون غيره، لذلك نرى بأنّ الإستنكار والتنديد بمرتكبي الفاجعة العظمى ومسبّبيها لم يخصّ المسلمين وحدهم، بل شمل كلّ أحرار العالم على مدى الزمان، ومنه استنكار رسول قيصر ـ وهو من أهل الكتاب ـ الذي كان جالساً في مجلس يزيد، فلمّا رأى رأس الحسين بين يدّي يزيد تأثّر من ذلك وسأل عنه، فقيل له: هذا الحسين بن فاطمة بنت رسول الله’، فتعجّب وقال: «هذا ابن بنت نبيّكم؟! فقال يزيد: نعم، ففزع ممثّل ملك الروم، وقال: تبّاً لكم ولدينكم، وحقّ المسيح إنّكم على باطل، وإنّ عندنا في بعض الجزائر ديراً فيه حافر فرس ركبه المسيح، فنحن نحجّ إليه في كلّ عام مسيرة شهور وسنين، ونحمل إليه النذور والأموال، ونعظّمه كما تعظّمون كعبتكم، فأشهد أنّكم على باطل، ثمّ قام ولم يعد إليه»([1374]).
ثمّ إنّ يزيد أمر بقتله؛ خشيةً من أن يفضحه عند قومه بعد رجوعه إليهم، «فلمّا أحسّ النصراني بالقتل قال: يايزيد أتريد قتلي؟ قال: نعم، قال: فاعلم أنّي رأيتُ البارحة نبيّكم في منامي وهو يقول لي: يا نصراني، أنت من أهل الجنّة، فعجبت من كلامه حتى نالني هذا، فأنا أشهد أن لا اله إلّا الله، وأنّ محمداً رسول الله عبده ورسوله، ثمّ أخذ الرأس وضمّه إليه، وجعل يبكي حتى قُتِل»([1375]).
ويبدو أنّ رسول قيصر هذا كان مقيماً في دمشق، وممّا يُؤكّد ذلك ما أورده أبو يعلى، من أنّ رسول قيصر كان له منزل يقيم فيه هناك في عهد يزيد بن معاوية([1376]).
6 ـ رأس الجالوت([1377]):
ممَّن أظهر استنكاره وإدانته رأس الجالوت، حيث دخل على يزيد بن معاوية، فقال له: «ما هذا الرأس؟ فقال يزيد: رأس خارجي، قال: ومَن هو؟ قال يزيد: الحسين، قال: ابن مَن؟ قال يزيد: ابن علي، قال: ومَن أمّه؟ قال يزيد: فاطمة، قال: ومَن فاطمة؟ قال يزيد: بنت محمّد، قال: نبيّكم؟! قال يزيد: نعم، قال: لا جزاكم الله خيراً، بالأمس كان نبيّكم واليوم قتلتم ابن بنته! ويحك إنّ بيني وبين داود النبي نيفا وسبعين أباً، فإذا رأتني اليهود كفرت لي»([1378]).
يتّضح من هذه الرواية أنّ رأس الجالوت هو من أحفاد نبي الله داوود، وهو أشبه ما يكون بزعيم الطائفة اليهودية، ويحظى عندهم بمنزلة ملؤها الوقار والإحترام.
7 ـ حبر يهودي([1379]):
كان حبر يهودي حاضراً في مجلس يزيد بن معاوية، ويبدو أنّه قد جلب انتباهه علي بن الحسين، فسأل يزيدَ عنه، فأجابه بأنّ صاحب الرأس هو أبوه، ثمّ سأل الحبر يزيدَ ثانيةً، من هو صاحب الرأس؟ فأجابه هو الحسين بن علي بن أبي طالب، ثمّ سأل الحبر عن أمّه، فأجابه بأنّها فاطمة بنت محمّد، فقال الحبر: «يا سبحان الله! هذا ابن بنت نبيّكم قتلتموه في هذه السرعة، بئس ما خلّفتموه في ذريّته، والله لو خلّف فينا موسى بن عمران سبطا من صلبه لكنّا نعبده من دون الله، وأنتم إنّما فارقكم نبيّكم بالأمس فوثبتم على ابن نبيّكم فقتلتموه، سوأة لكم من أمّة»([1380]).
فأمر يزيد بكرّ في حلقه، فقام الحبر وهو يقول: «إن شئتم فاضربوني أو فاقتلوني أو قرّروني فإنّي أجد في التوراة أنّه مَن قتل ذريّة نبي لا يزال مغلوبا أبداً ما بقي، فإذا مات يصليه الله نار جهنّم»([1381]).
وممّا تقدّم يمكن القول أنّ الرفض لفعل يزيد بن معاوية بقتله الحسين بن علي لم يقتصر على المسلمين، بل شمل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، الذين كانوا يسألون يزيد كثيراً عن اسم الحسين×، ومَن هما أبواه، ومَن جدّه، ولم تكن هذه الأسئلة عادية وعابرة، بل ليتأكّد أصحابها ممّا سمعوه في الخارج. وهذا يعني أنّ قتل الحسين× وسبي عياله صار أمراً معروفاً وشائعاً في الوسط الشعبي والرسمي في دمشق، وأنّ التضليل الأموي بات مكشوفا، وأنّ ما روّج إليه يزيد وأعوانه من كون هؤلاء من الخوارج قد بُدّد، وصار في خبر كان.
ومن المسلمين الذين اعترضوا على يزيد هو الصحابي أبو برزة الأسلمي على نكت يزيد بعصاه شفَتَي الحسين، تلك التي كان النبي يقبّلهما. وكذلك الصحابي واثلة بن الأسقع، الذي ردّ على أولئك الذين كانوا فرحين بقتل الحسين×، بأنّه ما يزال يحبّ النبي’ وآل بيته، وهذا تحدٍّ لأعداء آل البيت. بل امتدّ الرفض والإدانة إلى ألدّ أعداء آل البيت، أمثال مروان بن الحكم، الذي سمع من الأمراء المصاحبين لقافلة سبايا آل البيت بقتل الحسين× وسبي عياله، فلم يقع هذا الأمر في نفسه موقع الرضا، بل عبّر عن رفضه بانسحابه عنهم. وكان موقف أخيه مروان رافضاً لتلك الجريمة أيضا، فقد أكّد يحيى بن الحكم لقتلة الحسين بأنّهم سيُحجبون عن محمّد وشفاعته يوم القيامة، وسوف لا يكون معهم في أيّ أمر ما مستقبلاً. وعندما وضع رأس الحسين× في طشت أمام يزيد بكى عبد الرحمن بن الحكم، وأنشد شعراً ذمّ فيه حسب ونسب ابن زياد، فأسكته يزيد؛ لأنّه لا يريد ذمّ مَن نفّذ أوامره بقتل الحسين. وصبّ يزيد جام غضبه على مؤذّن الجامع الأموي، الذي ساعد الإمام علي بن الحسين÷ على صعود المنبر ليخطب، وبخطبته فُضِح يزيد أمام حضور مجلسه، وعدّ يزيد ذلك بأنّ المؤذّن يريد زوال حكمه، إلّا أنّ يزيد أقرّ لمؤذّنه أنّه من بيت النبوّة ومعدن الرسالة، ممّا وضع نفسه في زاوية حرجة، فتشجّع المؤذّن ولامه على قتل الحسين، ولم يجد يزيد جواباً لذلك إلّا الأمر بقتله؛ لإسكات الأصوات الرافضة لأفعال بني أميّة.
كما استمر رفض أهل الكتاب من النصارى واليهود لفعل يزيد ، إذ أثارت مشاعرهم تلك الجريمة النكراء، فقد رفض رسول قيصر النصراني عندما علم أنّ هذا رأس الحسين بن علي÷ حفيد النبي، فوصف يزيدَ وأصحابه بالباطل، وخرج من المجلس، إلّا أنّ يزيداً لم يتركه وحاله، بل أمر بقتله خشيةً من أن يفضحه في الوسط النصراني، وقبل قتله أسلم ذلك النصراني، وحضن رأس الحسين وبكى بكاءً شديداً. وأما اليهود فقد كان إثنان منهم جالسين في المجلس، فرفضا قتل الحسين× وأدانا من فعل ذلك، فكان أولهما هو رأس الجالوت، الذي رأى رأس الحسين، فسأل عن أبيه وأمّه وجدّه، وعندما أُجِيب على سؤاله أغضبه ذلك، ولم يدع لهم بالخير. وثانيهما الحبر الذي جلب انتباهه الإمام علي بن الحسين÷، وسأل عنه، فأجابه يزيد بأنّه ابن صاحب هذا الرأس، وعندما عرف الحبر أنّ المقتول هو سبط النبي’ إنتابه الغضب ووصف يزيد وأمّته أنّها أسوأ الأمم، فعاقبه يزيد بوضع كرٍّ في حلقه، وعند ذلك أخبرهم الحبر أن في التوراة إشارة إلى أنّ مَن يقتل ذريّة نبي سيظلّ مغلوباً في الدنيا، وفي الآخرة له نار جهنّم.
لقد إنتبه أهل الشام من غفلتهم حين عرفوا حقيقة الأمر، فرفضوا ذلك وأقاموا العزاء، وعطّلوا أسواقهم، وواسوا سبايا آل البيت. و وصلت هذه الأخبار إلى يزيد، من أنّ أهل الشام بدأوا يتحدّثون عن قتل الحسين×، ويقولون: «والله ما علمنا أنّه رأس الحسين، وإنّما قيل رأس خارجي خرج بأرض العراق»([1382])، وأنّ الغضب عليه أخذ يزداد عند النّاس، لدرجة أنهم أرادوا الهجوم على قصره وقتله. وعند ذلك جاءه مروان ابن الحكم ـ ناصحاً ـ فقال ليزيد: «لا أرى بقاء أولاد الحسين وعياله وأهل بيته عندك إلّا مضرّاً بمصلحة ملكك، فاعمل على ترحيلهم من الشام إلى المدينة، الله الله في ملكك لئلا يندثر بسبب هؤلاء العيال»([1383]).
كما فشل يزيد في محاولة إبتدعها، وذلك بإشغال النّاس ـ عن جريمته التي إرتكبها بحق الحسين بن علي÷ وأهل بيته ـ بوضع أجزاء من القرآن الكريم في المسجد؛ لينشغل المسلمون عن ذكر الحسين× بقراءتها بعد الإنتهاء من صلاتهم ، إلّا أنّ هذا لم يتمّ، بل ظلّ المسلمون يذكرون الحسين×، وينددون بقاتله([1384]).
وهنا نرى أنّ يزيد اتّخذ من القرآن الكريم وسيلة لإبعاد المسلمين عن الحديث بجريمته، ولم يتّخذه دستوراً في منهج إدارته للدولة.
وهكذا لم تمض مدّة طويلة على بقاء آل البيت في الشام، إذ تبدّلت نبرة يزيد ومعاملته مع سبايا آل البيت؛ لأنّ التغيّرات الفكرية لدى أهل الشام، وانكشاف الحقائق لهم؛ جعلت يزيد يسارع في استشارة المقرّبين له في كيفية التصرّف مع قضية آل البيت، حيث سألهم: «يا أهل الشام ماذا ترون في هؤلاء؟ فقال له رجل: لا تتّخذنّ من كلب سوء جرواً([1385])، فقال له النعمان بن بشير: اصنع ما كان رسول الله يصنع بهم لو رآهم بهذه الخربة»([1386])، وعند ذلك رقّ عليهم يزيد، وبعث بهم إلى الحمّام، وأجرى عليهم الكساوى والعطايا والأطعمة، وأنزلهم في داره([1387]).
إنّ فعل يزيد هذا ليس حبّاً لآل البيت، وإنّما لإبعادهم عن النّاس الذين بدأوا يميلون إليهم.
وقيل: إنّه جاء رجل من أصحاب رسول الله’ وقال ليزيد: «قد أمكنك الله من عدوّ الله وابن عدوّ أبيك، فاقتل هذا الغلام ـ يعني علي بن الحسين - ينقطع هذا النسل؛ فإنّك لا ترى ما تحبّ وهم أحياء مَن ينازع فيه، يعني علي بن الحسين، لقد رأيت ما لقي أبوك من أبيه، وما لقيت أنت منه، وقد رأيت ما صنع مسلم بن عقيل، فاقطع أصل هذا البيت؛ فإنّك إن قتلت هذا الغلام انقطع نسل الحسين خاصّة، وإلّا فالقوم ما بقي منهم أحد طالبك بهم وهم قوم ذووا مكر، والنّاس إليهم مائلون، وخاصة غوغاء أهل العراق، يقولون: ابن رسول الله ابن علي وفاطمة، اقتله فليس هو بأكرم من صاحب هذا الرأس، فقال يزيد : لا قمت ولا قعدت، فإنّك ضعيف مهين، بل أدعهم، كلمّا طلع منهم طالع أخذته سيوف آل أبي سفيان»([1388]).
إنّ هذه الرواية تبيّن لنا
أنّ يزيد بن معاوية ومن ورائه بنو أميّة، مبدأهم مع كلّ مَن ينازعهم سلطتهم يكون
مصيره القتل أيّاً كان، ومع أنّ الحسين بن علي÷
لم يكن منازعاً لبني أميّة على السلطة؛ لأنّه لا يرى قيادة الأمّة سلطة يتولّاها
المرء ليتحكّم برقاب النّاس، بل الحكم بالعدل بينهم، ووفقاً لتعاليم الشرع
الإسلامي.
لقد دعا يزيد الذين حضروا قتل الحسين×، فحضروا بين يَدَيه، فسألهم قائلاً: «ويحكم مَن قتل الحسين؟ فجعل بعضهم يحيل على بعض، فقال يزيد: ويحكم أراكم يحيل بعضكم على بعض، قالوا يا يزيد: قتله قيس بن الربيع([1389])، فقال له: أنت قتلت الحسين؟ فقال: كلا ما أنا قتلته، قال يزيد: فمَن قتله؟ قال قيس: أقول لك مَن قتله ولي الأمان؟ قال يزيد: قل ولك الأمان، قال قيس: والله ما قتل الحسين وأهل بيته إلّا مَن عقد الرايات، وصبّ المال على الأنطاع([1390])وسيّر الجيوش، فقال يزيد: ومَن ذلك؟ قال قيس: أنت والله يا يزيد، فغضب يزيد ونهض ودخل داره ووضع الرأس في طشت، وغطّاه بمنديل ديبقي([1391])، وقيل وضعه في حجره، وجعل يلطم على خدّه ويقول: ما لي وقتل الحسين»([1392]).
إنّ أبا مخنف في روايته هذه لم تكن بالشكل الذي تُصدّق من قِبَل المطّلع عليها، فهي تُثير عددا من الأسئلة، مضافا إلى أنّنا نشمّ منها رائحة أموية تهدف إلى تبرئة يزيد بن معاوية من قتله الحسين× ورجال بيته وأنصاره، وإظهار شديد أسفه على ما حلّ بهم.
وهنا نقول: هل أنّ يزيدا يجمع عدداً من أمرائه، ليسألهم عن من قتل الحسين؟ وهل فعلاً أنّه لا يعرف ذلك! فمَن هو الذي أ صدر أوامره بقتل الحسين؟! ثمّ إنّ قيس بن الربيع (ت168هـ/784م) شخصية زجّت في الموضوع زجّاً، وهنا يبدأ الضعف والإرباك في الرواية، فإنّ قيس تُوفي في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، أي بعد حادثة قتل الحسين بفترة تجاوزت قرناً من الزمن، ولم تذكر المصادر التي اطّلعنا عليها اسم قيس بن الربيع وأنّه قتل الحسين، أو جاء ذكره مع القادة الذين شاركوا بقتله أو سبي عياله. ثمّ لو سلّمنا بأنّ قيساً كان موجوداً، وهو الذي قام بقتل الحسين، فكيف يجرأ على خطاب يزيد باسمه الصريح دون مخاطبته بلفظ أمير المؤمنين؟! وهنا لا يمكن الاعتماداً على الأمان الذي أعطاه إيّاه يزيد، الذي قام بقتل أيّ رافض لقتل الحسين، كالشيخ الشامي، ومؤذّن مسجده، وآخرين من أهل الذمّة، فكيف نصدّق أنّ يزيد تقبّل ذلك، ودون أي ردّة فعل، وأنّه ما إن سمع قول قيس تغيّرت أحواله ودخل داره غاضباً، وبدأ يلوم نفسه باكياً لاطماً خدّه ورأس الحسين في حجره، وفي الوقت ذاته أشارت الرواية إلى أنّ الرأس في طشت مغطى بمنديل؛ وعليه فإنّ هذه الرواية واهية، ولا يمكن الإعتماد عليها، بل هي في محلّ نظر وتأمّل.
وفي هذا الوقت تغيّرت معاملة يزيد لسبايا آل البيت، فاإهّ دعا الحُرم واعتذر إليهنّ، وقال لهنّ: «أيما أحبّ إليكنّ المقام عندي، أو المسير إلى المدينة»([1393])، وفي رواية أخرى أنّ يزيد وجّه كلامه هذا إلى علي بن الحسين÷، قائلاً له: «إن شئتَ أقمتَ عندنا فبررناك، وإن شئتَ رددناك إلى المدينة؟ فقال علي: لا أريد إلّا المدينة»، فردّه يزيد إليها مع أهله([1394]).
وفي وقت الحوار هذا أنزل يزيد الإمام السجّاد ونسوة آل البيت في داره، حيث أقاموا فيها أيّاماً([1395])، وأمر يزيد بإدخال نسائه على نساء آل البيت، فأقمنَ المأتم على الحسين ثلاثة أيّام، فما بقيت امرأة من نساء آل أبي سفيان إلّا تلقتهنّ تبكي وتنتحب([1396])، وألقينَ ما عليهن من الحلي والحلل([1397]).
وفي رواية أخرى أنّ زينب هي التي أرسلت إلى يزيد ليأذن لهنّ بإقامة العزاء على الحسين بن علي، فأذِن لهنّ يزيد، وأمر بإدخالهنّ إلى دار الحجارة([1398])، فأقمنَ العزاء، وكثُر بكاؤهن، واجتمعت النساء عليهنّ كلّ يوم، واجتزنَ حدود الحصر([1399]) والإحصاء([1400])، وأصبح يزيد يستميل علي بن الحسين، فلا يتغدّى ولا يتعشّى إلّا وعلي بن الحسين معه([1401])، وصار يستدعي علياً ويجلسه إلى جانبه، ويتفدّاه ويتذلّل له، ويُظهر الحزن على أبيه، ويلعن ابن زياد، ويدّعي أنّه لو كان صاحب الحسين لما وصل الأمر إلى هذا الحدّ([1402]).
وبعد سماح يزيد بإقامة مأتم العزاء سأل علي بن الحسين÷، بأن يذكر حاجاته الثلاث التي طلبها ليقضيها له. فكانت الحاجة الأولى: هي رؤيته وجه أبيه الحسين؛ ليتزوّد منه وينظر إليه ويودّعه. والثانية: ردّ ما أخذ من أهل البيت. والثالثة: فيما إذا عزم يزيد على قتله ـ أي على قتل علي بن الحسين ـ أن يُوجّه مع هذه النسوة من يردهنّ إلى حرم جدهنّ، أي إلى المدينة. وكان جواب يزيد لا سبيل لرؤية الرأس أبداً، ولا قتل لعلي بن الحسين، بل هو الذي يتولّى ردّ نساء أهل بيته إلى المدينة([1403])، وردّ ما أخذ من سبايا آل البيت لهم أضعافاً([1404]).
ويبدو ممّا تقدّم أن في أحد اللقاءات تعهّد فيه يزيد بقضاء ثلاث حاجات طلبها علي بن الحسين، ووفاء يزيد بتعهّده في قضائها مع تعاليه وتكبّره، باستثناء رؤية علي لرأس أبيه الحسين.
وممّا يُؤاخذ على هذه الرواية أنّه كيف يطلب الإمام السجّاد رؤية رأس أبيه ولا يطلب أخذ رأس أبيه الحسين وبقية رؤوس القتلى؛ لتأخذ طريقها إلى الدفن وفق الشرع الإسلامي؟! كما أنّ مطاليب أهل البيت لم تكن مادّية، بل إرجاع ما سُلِب منهم يوم الطفّ؛ لأنّه من المواريث الخاصّة لفاطمة بنت النبي، وهذا ما جاء في قول علي بن الحسين ليزيد: «أما مالك فلا نريده، فهو موفّر عليك، وإنما طلبت منك ما أُخذ منا، لانّ فيه مغزل فاطمة بنت محمد، ومقنعتها وقلادتها وقميصها»([1405])، وأمّا طلب علي بن الحسين÷ في جعل أحد يُوصل نساء آل البيت وأطفالهنّ إلى المدينة المنوّرة، فلأنّه كان يخشى القتل من قبل يزيد، وإن أظهر التودّد والتذلّل لعلي بن الحسين، وهذا ما أشار إليه علي بن الحسين÷ في حديثه مع المنهال بن عمرو، إذ إنّهم يترقّبون الموت في أي لحظة.
ومما جاء عن يزيد أنه دعا علي بن الحسين÷ وعمرو
بن الحسن، وهو غلام صغير، وقال لعمرو بن الحسن: «أتقاتل
هذا الفتى؟ يعني خالداً([1406])ابنه،
فقال
عمرو : لا، ولكن أعطني سكيناً وأعطه
سكيناً، ثمّ قاتله فأخذه ـ يزيد ـ وضمّه إليه، ثمّ قال يزيد: شنشنةٌ([1407])أعرفها من
أخزم، هل تلد الحية إلّا الحية؟»([1408]).
وفي رواية أخرى، عن محمّد بن عمرو بن الحسن بن علي، لما قتل الحسين، وحمل رأسه إلى يزيد، وحملنا معه فأقعدني يزيد في حجره، وأقعد إبناً له في حجره، فقال لي: «أتصرعه؟ فقلتُ: أعطني سكيناً وأعطه سكيناً، ودعني وإياه، فقال يزيد: ما تدعون عداوتنا صغاراً وكباراً»([1409])، وأشارت رواية أخرى أيضا أن يزيد طلب من علي بن الحسين÷، مصارعة ابنه([1410]).
ويُلاحظ على هذه الروايات أنّها تطلب من أناس يعيشون الحزن والألم ـ نظراً لقتل رجالهم وسبي نسائهم ـ الدخول في مصارعة ، فبأيّ حال هؤلاء ليجيبوا طلب يزيد، وهم في مصيبة كبرى! ثمّ مَن الذي طُلِب منه القتال أو المصارعة، هل هو عمرو بن الحسن، أم ابنه محمّد، أم علي بن الحسين، إنّ عمرواً كان صبيّاً صغيراً، ولا يمكن أن يكون له ولد، وأمّا علي بن الحسين فلا يُعقل أن يستجيب لذلك؛ لأنّ عمره وشخصه لا يتناسبان وطلبات يزيد المتهوّر. ثمّ الكلّ يعلم شجاعة بني هاشم عامةً، وآل البيت خاصّة؛ فكيف يمكن ليزيد أن يطلب طلبا يؤدّي الى قتل ولده.
بعد أن استقّر رأي السبايا على العودة إلى المدينة، لأنّها مهاجرة جدّهم محمّد المصطفى’، أخبروا يزيد بذلك، فأمر النعمان بن بشير الأنصاري أن يُهيئ وسائل السفر لترحيل أهل البيت من دمشق إلى المدينة([1411]).
وعندما خرج الركب الحسيني أوصى يزيد الحرس المرافقين لهم، بأن يرفقوا بهم، ويعاملوهم بكل إحسان([1412])، وأصحبهم النعمان بن بشير رسولاً، وأوصاه بأن يسير بهم في الليل، ويكونوا أمامه وتحت نظره لا يغيبون عن عينه([1413]). كما أمر يزيد الحرس الذين صحبوا السبايا أن ينزلوا بهم حيث شاؤوا، ومتى شاءوا([1414])، فإذا نزلوا تنحّى عنهم، وتفرّق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم، بحيث إن أراد إنسان من جماعتهم وضوءاً وقضاء حاجة لم يحتشم. وسار معهم في جملة النعمان، ولم يزل ينازلهم في الطريق ويرفق بهم ويرعاهم، كما أوصاه يزيد بذلك، حتى دخلوا المدينة([1415]).
أما المدّة التي قضاها سبايا آل البيت في مدينة دمشق فلم تذكرها المصادر التي بين أيدينا بشكل دقيق، بحيث يكون منسجماً مع ما يُعقّل من مجرى الأحداث، ولكن يمكن حسابها تقريباً واحتمالاً من إشارات بعض الروايات، فنتّخذها أساساً لحساب مدّة بقاء آل البيت في دمشق، وذلك بعد أن نستبعد الروايات التي تبالغ في ذكرها بعض الأحداث، ومنها رواية القاضي النعمان المغربي، والتي تُشير إلى أنّ مدّة بقاء سبايا آل البيت في دمشق ـ والتي بضمنها مدّة السجن ـ كانت شهرا ونصفا([1416]). وكذلك رواية ابن طاووس التي حدّدت مدّة بقاء سبايا آل البيت بشهر في السجن([1417]).
لقد أشار البيروني إلى أنّ رأس الحسين قد قُدّم أمام يزيد في الأول من صفر([1418])، وأنّ قافلة السبايا عند وصولها إلى الشام انتظرت على باب من أبواب سور دمشق ثلاثة أيام؛ لإكمال إجراءات الإحتفال الذي أمر به يزيد بن معاوية، ثمّ أُجرِي استعراض سبايا آل البيت في اليوم الرابع، واستمرّ من الصباح الباكر إلى ما بعد الظهر، ثمّ أُدخِلوا إلى مجلس يزيد العام، وبعد انتهاء المجلس أمر يزيد بإيداع آل البيت السجن، ولم نعرف المدّة التي قضوها فيه، ولكن خلال مدّة السجن يبدو أنّ العامّة من النّاس تعاطفوا مع آل البيت بعد أن عرفوا ما حلّ بهم، وبدأوا يدخلون عليهم في السجن، أو يلتقون بهم في شوارع دمشق، كما حصل ما بين علي بن الحسين والمنهال بن عمرو، ممّا زادت خشية يزيد من هذه التطوّرات، وبالتالي انقلاب الأمر عليه؛ فأخرجهم من السجن، وأنزلهم في دار إلى جانب قصره، لمنع تواصل اللقاءات بين النّاس وسبايا آل البيت. ومع ذلك أُقيم في هذه الدار مأتم عزاء على الحسين×، شاركت فيه نساء بني أميّة لمدّة ثلاثة أيام([1419])، وبهذا فإنّ سبايا آل البيت قضوا ثلاثة أيّام إلى جوار سور دمشق، ويوم الاستعراض، وثلاثة أيّام مدّة العزاء في دار قرب قصر يزيد، فيكون مجموع هذه الأيّام يكون سبعة أيّام.
وتبقى مدّة السجن مجهولة، ولكنّها في الأعمّ الأغلب لا تتجاوز ثلاثة أيّام، إذا ما قُورنت بتأزّم الوضع في دمشق، وميل النّاس وتعاطفهم مع سبايا آل البيت، وبضمنهم نساء بيت يزيد، وخشية بني أميّة من ذلك؛ ممّا جعلهم ينصحون يزيد بإخراج السبايا من دمشق، وإرجاعهم إلى المدينة المنوّرة. وبهذا يمكن القول إنّ سبايا آل البيت قضوا مدّة عشرة أيّام، أو أكثر قليلاً في دمشق، أي أنّهم خرجوا منها متوجّهين إلى المدينة في العاشر من صفر، أو بعده بيوم أو يومين.
ولابد من الإشارة هنا ـ ونحن نأتي على نهاية هذا الفصل ـ إلى أنّنا لم نجد أيّ مطالبة من قبل سبايا آل البيت، ولاسيما من علي بن الحسين وعمّته السيّدة زينب بنت علي^، برأس الإمام الحسين× وبقية رؤوس القتلى، سوى طلب علي بن الحسين من يزيد رؤيته لرأس أبيه الحسين×، وهذا الطلب لم يوافق عليه يزيد بن معاوية. وسوف نقوم بدراسة هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الفصل القادم.
الفصل الخامس
رأس الإمام الحسين بن علي÷ ومدفنه
المبحث الأول: قطع الرؤوس وأبعادها السياسية والإجتماعية
المبحث الثاني: مدفن رأس الإمام الحسين بن علي÷
قطع الرؤوس وأبعادها السياسية والاجتماعية
إنّ المتتبّع لأحداث التاريخ الإسلامي يجد أن قطع رؤوس القتلى وإرسالها من مدينة إلى أخرى، والطواف بها في شوارع تلك المدن، ثقافة أموية أُشِيع استعمالها منذ عهد حكم معاوية بن أبي سفيان (41 ـ60هـ/661 ـ679م)، وصار جزءاً من ممارساتهم الأخلاقية، ويبغون من ورائه إسكات كلّ الأصوات المعارضة لمفاسدهم، والتي لم تسر في خطّهم ولم تؤيّدهم في سياساتهم وتولّيهم الحكم. وهذه الثقافة الغريبة عن مبادئ الإسلام لم تكن معروفة عند المسلمين؛ لأنّ الإسلام يعدّ قطع رأس الإنسان بعد موته من المُثلة([1420])، وإنّ الرسول’ نهى عن أن يمثّل بالدوابّ، أي تنصب ثمّ ترمى، أو تُقطع أطرافها وهي حية([1421]).
كما نهى الرسول’ عن المثلة فقال: «إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور»([1422])، فكيف بالإنسان؟! وثبت عن الرسول’ النهي عن ذلك، ولم يحدث في عهده بالرغم من كثرة الحروب التي خاضها المسلمون ضدّ المشركين، ولم يرد أنّه سمع بذلك ورضي بشيء منه([1423]).
أمّا في عصر الخلفاء الأربعة فلم تحدث في عهدهم، على الرغم من كثرة الحروب التي خاضها المسلمون لنشر الإسلام، ولاسيما ضدّ الإمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، إلّا حالة واحدة مع العرب المسلمين، حدثت في عهد أبي بكر (11 ـ13هـ/632 ـ634م)، عندما هاجم خالد بن الوليد وجيشه الصحابي مالك ابن نويرة([1424]) وقومه في أماكن سكناهم، إذ عدّهم من المرتدّين، فعمل على قطع رؤوس مَن قُتِل منهم، إلّا أنّ هذه الحادثة أثارت حفيظة المسلمين، رفضاً واستنكاراً، حتى أنّ عمر بن الخطاب (13ـ23هـ/634ـ643م) لم يكن راضياً عمّا فعله خالد بن الوليد وأنكر عليه فعلته تلك([1425]).
إنّ الأمويين هم الذين أشاعوا ثقافة قطع رؤوس القتلى والطواف بها، فانتهكوا بأفعالهم هذه الحكم الشرعي الإسلامي الواضح المانع لتلك الأفعال، ولا نعرف من أين أخذ الأمويون هذا الفعل، ولعلّه من آثار العقلية الجاهلية التي لم يتخلّصوا منها بعد، ولم يغادروها إلى فكر إسلامي متنوّر، ملؤه السماحة والمحبّة، أو ربما أخذوها من الأمم المجاورة لهم، كالروم الذين عمل الأمويون على تقليدهم في كثير من نواحي حياتهم وطرق معيشتهم([1426]).
عندما اتّبع معاوية بن أبي
سفيان والي الشام المعزول سياسة التوسّع في نفوذه، وعدم اعترافه بخلافة الإمام علي
بن أبي طالب×الشرعية،
أرسل جيشاً إلى مصر سنة 38هـ/658م، وجرت حرب بينه وبين والي مصر محمّد بن أبي بكر([1427])
(37ـ 38هـ/657 ـ658م)، إبّان خلافة الإمام علي بن أبي طالب×، وتمكّن جيش معاوية من
الإمساك بوالي مصر محمّد بن أبي بكر وقتله وقطع رأسه، وحمله من مصر إلى دمشق وقُدِّم
إلى معاوية، وأمّا جثته فأدخلت في جيفة حمار وأُحرقت([1428]).
كما قام الأمويون بقطع رأس الصحابي عمرو بن الحمق الخزاعي سنة 51هـ/671م، الذي كان متوارياً في الموصل بسبب مطاردة الأمويين له مدّة طويلة، وفقاً لسياستهم التي اتّبعوها ضدّ أصحاب الإمام علي بن أبي طالب×، وبعد أن وجده والي الموصل الأموي عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي([1429]) ميتاً في غار من نهشة أفعى قطع رأسه من جثته، وحُمِل إلى معاوية في دمشق، ثمّ طِيف به في المدينة([1430]).
إنّ فعل الأمويين هذا، بقطع الرؤوس من الأجساد الميتة، ثمّ حرق بعض تلك الأجساد؛ يدلّ على وحشية بربرية، وانسلاخ عن قيم الأرض والسماء على حدّ سواء، ولا تقرّه الأديان المختلفة، بما فيها الإسلام والمسلمون الحقيقيون، وإنّ قتل وقطع رأس محمّد بن أبي بكر سبق قتل وقطع رأس الإمام الحسين بن علي÷ بأكثر من اثنتين وعشرين سنة، وقطع رأس عمرو بن الحمق الخزاعي سبق قطع رأس الإمام الحسين× بحوالي عشر سنوات. ويبدو أنّ أخبارهما لم تنتشر بين المسلمين بشكل واسع، وإن طِيف برأسيهما كما أشار بعض المؤرِّخين إلى أولوية ذلك([1431])، إلّا أنّ الطواف برأسَيهما كان على نطاق ضيق لا يتعدّى مساحة المدينة الواحدة، قياساً إلى الطواف برأس الإمام الحسين بن علي÷ بين مدن متعدّدة ومتوالية ومتجاورة، تقع على الطريق الطويل بين الكوفة ودمشق، واستمّر فيه المسير أيّاماً وليالياً، وهذا يعني أنّ رأس الإمام الحسين× ـ وهو سبط نبيٍ لا يوجد غيره في شرق الأرض ولا غربها ـ أوّل رأس حُمِل ونُقِل وطِيف به بين المدن العربية الإسلامية.
وعندما بدأت ثورة الإمام الحسين بن علي÷ تلوح في الأفق، وتجري الإستعدادات لها في الكوفة، ضيّق عبيد الله بن زياد الوالي الأموي في الكوفة بشدّة على المؤيّدين لثورة الحسين، بإلقاء القبض عليهم، والأمر بقتلهم وقطع رؤوسهم. وهذا ما حصل لأكبر شخصيتينِ هما: مسلم بن عقيل× وهانئ بن عروة، ثمّ بعث برأسَيهما إلى يزيد بن معاوية في دمشق([1432]). بينما نجده عند قتله مجموعة أخرى من المؤيّدين لثورة الحسين في البصرة والكوفة لم يرسل برؤوسهم إلى دمشق، بل قام بصلب بعضهم عدّة أيّام وتقطيع أجسادهم؛ لأنّهم من الأفراد العاديين بنظره، ومن الموالي الذين لا يشكّلون رقماً يُعتدّ به من قبل بني أميّة وأعوانهم، فقد قتل سليمان ابن رزين([1433]) مولى الإمام الحسين بن علي÷ ورسوله إلى أهل البصرة لإيصال كتابه إليهم، في الليلة التي غادر في صباحها إلى الكوفة عبيد الله بن زياد؛ ليتولّى ولايتها تنفيذاً لأمر يزيد بن معاوية([1434]). وفي الكوفة قبض على رسول الحسين إلى أهلها، قيس بن مسهر الصيداوي([1435])، وتم قتله([1436])، وقبض على عبد الله بن يقطر([1437])، رسول الإمام الحسين× إلى مسلم بن عقيل الذي كان موجوداً في الكوفة وقتله([1438])، وعلى قول قبض على رشيد الهجري وقتله([1439])، وكذلك قتل الصحابي ميثم بن يحيى التمّار الأسدي، الذي صلبه([1440]) ابن زياد عاشر عشرة في الكوفة، وكان ذلك قبل وصول الإمام الحسين× إلى الطفّ بعشرة أيام([1441]).
إنّ عدم إرسال ابن زياد لرؤوس مَن قتلهم من الرجال العشرة في الكوفة إلى دمشق؛ لأنّهم لم يكونوا من حيث قوّة التأثير السياسي كمسلم بن عقيل، فهو من بني هاشم، وابن عمّ الإمام الحسين بن علي÷، وثقته من أهل بيته، ورسوله إلى أهل الكوفة، وهو الذي جمع أعداداً من المقاتلين؛ ليقفوا مع الإمام الحسين× القادم إلى الكوفة للثورة على بني أميّة، وجمع الأموال لدعم زخم الثورة المتصاعد من حيث التسليح والتدريب. ولا مثل هانئ بن عروة رئيس قبيلة مذحج الكبيرة في الكوفة.
بهذا يريد ابن زياد أن يُوحي لخصوم بني أميّة بأنّه لا يقف أمامهم أيّ تيّار سياسي معادٍ لهم، مهما بلغت مكانته وتأثيره، ولا أيّ قوّة قبلية تمتاز بحجمها الكبير في الكوفة أو غيرها، بل إنّ مصيرهم القتل وسبي العيال، كما حصل للإمام الحسين ابن علي÷ وآل بيته وأنصاره.
كما قُطِعت رؤوس قتلى معركة الطفّ بأمر من عمر بن سعد قائد الجيش الأموي([1442])، وإنّ ابن سعد لم يقم بهذا الفعل من تلقاء نفسه، وإنّما بناءً على أوامر تلقّاها من ابن زياد([1443])، ليؤكّد ولاءه وإخلاصه لبني أميّة، ويُعزز مكانته عندهم، ويظهر لهم بأنّه أنجز المهمّة التي أُوكلت إليه، فقد أمر بقطع رأس الإمام الحسين× سبط النبي’ في يوم المعركة، وأرسله إلى ابن زياد في الكوفة عصر ذلك اليوم([1444])، وقُطِعت رؤوس بقية القتلى بعد ظهيرة اليوم الحادي عشر من المحرّم عندما تحرّك ابن سعد بركب السبايا إلى الكوفة، مصطحبا معه رؤوس القتلى([1445])، وبعد مدّة قصيرة أمضتها الرؤوس في الكوفة لإتمام الاستعراض أرسلها ابن زياد إلى الشام([1446])؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من النّاس لرؤية رؤوس القتلى والسبايا، الذين تمّ استعراضهم بين المدن التي مرّوا بها في طريقهم إلى الشام، بذات الطريقة التي جرت في الكوفة أو دمشق.
ومن الجدير ذكره هنا أن رؤوس قتلى الطفّ التي قُطِعت من الأجساد بعد يوم من المعركة تجاوز عددها السبعين رأساً([1447])، بينما أكّدت دراسات معاصرة بأنّ عدد قتلى بني هاشم وبضمنهم الإمام الحسين× كان تسعة عشر رجلاً([1448])، وعدد قتلى أنصار الحسين من غير الهاشميين كان خمسة وتسعين رجلاً، ولم تُقطع رؤوسهم جميعاً([1449])، وأُخِذت هذه الرؤوس مع ركب السبايا الذي يقوده عمر بن سعد إلى الكوفة، حيث استُعرِض بالجميع ـ الرؤوس والسبايا ـ في شوارع الكوفة ومحلّاتها([1450]).
ويبدو أنّ عدد رؤوس القتلى الذي استُعرض به في الكوفة لم يكن هو ذات العدد الذي استُعرِض به في شوارع دمشق وأسواقها، بل أقل، حيث اقتصر على رؤوس قتلى أهل بيت الإمام الحسين×، والتي لا تتجاوز تسعة عشر رأساً([1451]). وهنا يمكن أن نحتمل سبب تناقص عدد رؤوس القتلى في دمشق عن عددها في الكوفة، هو أنّ القبائل العربية ـ التي قاتل بعض رجالها مع الإمام الحسين في الطفّ ـ طالبت برؤوس قتلى رجالها، واستجاب ابن زياد لذلك؛ لتهدئة الأوضاع في الكوفة، ولاسيما أنّ قافلة السبايا ستتوجّه إلى الشام.
إنّ أفعال بني أميّة وأعوانهم قبل وبعد وفي أثناء معركة الطفّ، ما هي إلّا جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية، والتي صارت عنواناً لثقافتهم الانتقامية؛ لتحقيق غايات سياسية من خلال قطعهم رؤوس خصومهم بعد قتلهم والطواف بها، وإنّ قطع رؤوس القتلى خضع لعملية انتقاء للشخصيّات القيادية البارزة، فهم ومن وجهة نظرهم بعملهم هذا أرادوا إخماد الهالة القدسية التي تُحيط بالإمام الحسين× سبط النبي وأهل بيته، كما أنّ قطع رؤوس أصحاب الحسين من غير الهاشميين لم يكن اعتباطا، بل كان إجراء سياسياً؛ غايته إسكات كلّ الأصوات الحرّة، لأنّهم يشكّلون في غالبيتهم شخصيّات قيادية ويتبوّأون مراكز هامّة عند قبائلهم، ولهم أتباع يسمعون كلامهم ويتأثّرون بمواقفهم القبلية والسياسية.
ومن هنا جدّت السلطة الأموية في القضاء على أيّ توجّه قبلي أو جماهيري هدفه تقويض أو تأييد إسقاط النظام الأموي، ومن هنا فإنّ قتل الثوّار وقطع رؤوسهم والطواف بها سيكون عبرة إلى كلّ مَن يريد الخروج على بني أميّة، من الذين لم تتح لهم الفرصة في المشاركة في معركة الطفّ، على اعتبار أن ثورة الإمام الحسين× قد تمّ القضاء عليها، والدليل المادّي على ذلك هو قطع رؤوس القتلى، وفي مقدّمتها رأس الإمام الحسين بن علي÷، والطواف بتلك الرؤوس ليتفرّج عليها أهل المدن والقرى، ومن ثمّ يخبر الحاضر الغائب بأنّ ثورة الحسين فشلت ـ بحسب اعتقادهم البائس ـ وقُتل جميع ثوارها.
ومع كلّ ذلك يبقى ثمّة تساؤل هامّ وهو أين مكان مدفن رأس الإمام الحسين×؟ هذا ما سنتناوله في الصفحات القادمة.
مدفن رأس الإمام الحسين بن علي ÷
لم يسلم رأس الإمام الحسين× أسوةً بجسدهِ من أفعال بني أميّة، ذلك الجسد الذي تُرِك على الأرض ثلاثة أيّام من غير دفن، بعد أن رضّته الخيول بحوافرها ظهراً على صدر، فبعد أن قُطِع الرأس الشريف حُمل ذلك الرأس على رمح طويل، من بلد إلى بلد، أمام ركب قافلة سبايا آل البيت من النساء الثواكل والأطفال اليتامى، ويتفرّج عليه أُناس تلك المدن ما بين شامت فَرِح مسرور بالنصر المزعوم، وبين باكٍ متفجّع بتلك المصيبة بفقدان سبط النبي.
لم يتّعظ حكّام بني أميّة وأعوانهم من كرامة هذا الرأس الشريف وقدسيّته، وهو يقرأ آيات متعدّدة من القرآن الكريم، بل تمادوا في غيّهم وبغيهم، فصلبوا الرأس على أبواب الكوفة ودمشق أيّاماً، ثمّ راحوا في مجالسهم يشربون الخمر وينشدون الشعر حوله، ويحرّكون بالقضبان التي كانت في أيديهم تلك الشفاه التي كانت موضع تقبيل رسول الله|، ومعاقبة كلّ رافض لأفعالهم هذه، إلى أن انتهى المطاف به إلى مستقرّه الأخير، أي مكان دفنه الذي تعدّدت حوله الروايات.
ما نراه اليوم من هذه المقامات المشيّدة الكثيرة هي ليست قبراً للرأس الشريف، وإنّما أماكن وُضِع فيها الرأس عند نقله من الطفّ إلى الكوفة، ومن ثمّ إلى دمشق في الشام، وبهذا فإنّ مدفن الرأس الشريف واحد، ومقاماته متعدّدة، ولذا سنقوم بدراسة عدد من الروايات التي أشارت إلى موضع دفن رأس الإمام الحسين×، وهي:
1 ـ الشام: دمشق ـ الرقة ـ عسقلان.
2 ـ مصر: القاهرة.
3 ـ المدينة المنوّرة: البقيع([1452]).
4 ـ خراسان([1453]): مرو([1454]).
5 ـ العراق: الغري([1455]) (النجف) ـ الكوفة ـ الطفّ (كربلاء).
وسنبدأ الكلام عن هذه المواضع واحتمالات دفن الرأس الشريف فيها من الشام ومصر والمدينة المنوّرة ومرو، وأخيراً العراق.
ونودّ الإشارة هنا إلى أنّه في الوقت الذي اختلفت فيه الروايات التاريخية في موضع دفن رأس الإمام الحسين×، إلّا أنّها التزمت الصمت المطبق حيال دفن باقي رؤوس قتلى الطفّ، من رجال بني طالب وأنصار الحسين من غير الهاشميين.
لقد أشارت الروايات التاريخية إلى دفن رأس الإمام الحسين بن علي÷ في دمشق حاضرة بني أميّة، ومدن الرقّة وعسقلان، وتفصيل الكلام كما يلي:
لقد نُقِلت رؤوس قتلى الطفّ وفي مقدّمتها رأس الإمام الحسين× إلى يزيد بن معاوية، وذلك بصحبة قافلة سبايا آل البيت، كما ذكرنا آنفاً، وانقسمت الروايات التاريخية حول وقت مدفن الرأس إلى مجموعتين:
أولهما: ذهبت هذه الطائفة من الروايات إلى أنّ رأس الإمام الحسين× دُفِن في عهد يزيد بن معاوية (60ـ64هـ/679ـ683م) واختلفت في موضع الدفن. أشار البلاذري إلى أنّ يزيد بعث برأس الإمام الحسين× إلى المدينة المنوّرة، فنصب على خشبة ثمّ رُدّ إلى دمشق، فدُفِن في حائط([1456]) بها. وقيل: دُفِن في دار الإمارة. وقيل: دُفِن بمقبرة دمشق([1457]). بينما أشارت روايات أخرى إلى أنّ يزيد دفن الرأس في قبر أبيه معاوية، وقال: «أحصّنه بعد الممات»([1458]).
ثانيهما: ذهبت طائفة أخرى من الروايات إلى أنّ الرأس دُفِن بعد وفاة يزيد بن معاوية، واختُلِفت في موضع دفنه أيضا. أشار بعضها بأنه دُفِن في باب الفراديس([1459])، وحدّد ابن حبان الإختلاف في موضع دفن الرأس، فمنهم مَن زعم أنّه في البرج الثالث من السور على باب الفراديس بدمشق، ومنهم مَن زعم أنّ موضع الرأس تحت عمود في مسجد جامع دمشق عن يمين القبّة الخضراء([1460]). وفي رواية النويري أنّ قبر الحسين بكربلاء، ورأسه بالشام في مسجد دمشق على رأس اسطوانة([1461]).
وقيل أيضاً: إنّ الرأس كان ما يزال في خزانة([1462]) يزيد بن معاوية، وأخذ بعد وفاته من الخزانة، فكُفِّن ودُفِن داخل باب الفراديس بمدينة دمشق([1463]). وأشار ياقوت إلى هذا الأمر بشكل مقتضب، حيث ذكر أنّ في باب الفراديس مشهداً للحسين([1464]). بينما أشارت رواية أخرى إلى أنّ رأس الحسين مكث في خزانة السلاح الأموي إلى عهد سليمان بن عبد الملك([1465]) (96ـ 99هـ/714ـ717م)، حيث طلبه وأُحضِر له، ووجد أنّه صار عظماً أبيضاً قحلا([1466])، فجعل عليه ثوباً وأدخله في سفط، وصلّى عليه ودفنه في إحدى مقابر المسلمين بدمشق([1467]).
وتعيد روايات أخرى حديثها عن الخزانة ووجود رأس الحسين فيها إبّان أحداث الصراع على السلطة الأموية([1468])، بين الوليد بن يزيد بن عبد الملك (125ـ126هـ/743ـ744م)([1469])، وابن عمّه يزيد بن الوليد (ت126هـ/ 744م)([1470])، الذي انتصر على الأول وتولّى الحكم مدّة قصيرة لم تتجاوز خمسة أشهر. وفي تلك الأحداث دخل القائد العسكري الأموي منصور بن جمهور([1471]) خزانة يزيد بدمشق، وعندما فتحها وجد فيها جونة([1472]) حمراء، في داخلها رأس الإمام الحسين×، مخضّب بالسواد، فلفّه بثوب ودفنه عند باب الفراديس في البرج الثالث ممّا يلي المشرق([1473]).
ولقد ضعّف ابن كثير تلك الروايات التي أشارت إلى أنّ رأس الإمام الحسين× وُجِد في خزانة يزيد بن معاوية، ومن ثمّ دفنه عند باب الفراديس([1474]).
روى سبط بن الجوزي، عن عبد الله بن عمرو الوراق([1475]) المتوفى سنة274هـ/ 887م، ومصنّفه مقتل الحسين الذي يُعدّ من المصنّفات الضائعة، أنّه لمّا حضر رأس الإمام الحسين× بين يدي يزيد بن معاوية قال: «لأبعثنّه إلى آل أبي معيط([1476])عن رأس عثمان»وكانوا بالرقّة، فبعثه إليهم، فدفنوه في بعض دورهم، ثمّ أُدخِلت تلك الدار في المسجد الجامع وهو إلى جانب سدرة هناك، وعليه شبيه النيل([1477]) لا يذهب لونه شتاءاً ولا صيفاً([1478]).
وإنّ فعل يزيد هذا ـ إن صحّ إرساله الرأس للرقّة ـ يبيّن استمرار النهج الأموي بتحميل الإمام الحسين× جريمة قتل عثمان، كما حمّل أبوه معاوية ذلك الإمامَ علياً×، وهذا يعكس تجذّر الروح الجاهلية التي لم يتخلّص منها بنو أميّة.
لقد أشارت الروايات إلى أنّه عندما أُحضر رأس الإمام الحسين× عند يزيد، كان في مجلسه جماعة من أهالي عسقلان، فطلبوا منه أن يُدفن الرأس عندهم، فوافق على ذلك وسلّمه إليهم فدفنوه بمدينتهم، وبنوا عليه مشهداً يُزار، يُعرف بمشهد الرأس([1479]). وأكّد الهروي على أنّه يوجد مشهد للإمام الحسين× في عسقلان([1480])، وأشار سبط بن الجوزي إلى أنّ الخلفاء الفاطميّين هم الذين نقلوا الرأس من باب الفراديس إلى عسقلان([1481])، بينما أشار الشبلنجي إلى أنّه عندما أمر يزيد بن معاوية بالطواف برأس الحسين بين المدن، ووصل الرأس إلى مدينة عسقلان أخذه والي المدينة ودفنه في مدينته([1482]).
ثانياً: دفن رأس الإمام الحسين× في مصر
إنّ جميع الروايات التي أشارت إلى نقل رأس الإمام الحسين× إلى القاهرة في عهد الدولة الفاطمية، تعتمد بشكل كبير على ثبوت احتمال وجود الرأس في عسقلان، وإنّ الأخبار التي أشارت إلى نقله إلى القاهرة اتّسع نطاق الجدل فيها بين النفي والإثبات من قبل المؤرِّخين والباحثين قديماً وحديثاً، فقد أشار عدد من المؤرِّخين إلى وجود الرأس في عسقلان، ثمّ نقل فيما بعد إلى القاهرة بمصر ومنهم القلقشندي([1483])، والمقريزي([1484])، والشعراني([1485]) والشبلنجي([1486]). وأشار سبط بن الجوزي إلى أنّ الخلفاء الفاطميّين هم الذين نقلوا رأس الإمام الحسين× من باب الفراديس بدمشق إلى عسقلان ثمّ إلى القاهرة، وصار مشهداً عظيماً يزار([1487]).
ويُؤكّد ابن نما الحلي أنّ من أهل مصر مَن حدّثه بأنّ مشهد الرأس يسمّونه «مشهد الكريم»، وأنّ عليه شيئاً من الذهب الكثير، يقصدونه في المواسم ويزورونه([1488]).
وأكّد الرحّالة ابن جبير ـ الذي تُوفِي سنة 614هـ/1217م ـ على وجود رأس الإمام الحسين× في القاهرة عند زيارته لها، التي وصلها عصر الأربعاء في الحادي عشر من ذي الحجّة سنة 578هـ/1182م، وزار المشاهد مبتدئاً بمشهد رأس الحسين× الذي وصف زوّاره بقوله: «وشاهدنا من استلام النّاس للقبر المبارك، وإحداقهم به وانكبابهم عليه، وتمسحّهم بالكسوة التي عليه، وطوافهم حوله مزدحمين باكين، متوسّلين إلى الله سبحانه وتعالى ببركة التربة المقدّسة، ومتضرّعين ما يذيب الأكباد ويصدع الجماد، والأمر فيه أعظم، ومرأى الحال أهول، نفعنا الله ببركة ذلك المشهد الكريم»([1489]).
أمّا الرحّالة ابن بطوطة (ت779هـ/1377م) لم يذكر مشهد رأس الإمام الحسين× الموجود في القاهرة، بل أشار إلى أنّ رأس الحسين× كان موجوداً في عسقلان قبل نقله إلى مصر. ويُلاحظ على ابن بطوطة أنّه لا يذكر أية تواريخٍ عن زيارته لمدن الشام([1490]).
وجاء في سبب نقل رأس الحسين× إلى مصر، أنّ الصليبيين عندما قاموا بشنّ هجماتهم على بلاد الشام([1491]) تمكّنوا في الحملة الصليبية الثانية التي بدأت سنة 543هـ/1148م من الإستيلاء على عسقلان([1492]) سنة 548هـ/1153م، فافتدى الفاطميون رأس الحسين× بمال جزيل، ونقلوه إلى القاهرة في العام ذاته ودفنوه في الموضع المعروف فيه الآن([1493]).
ثالثاً: دفن رأس الإمام الحسين× في المدينة المنوّرة
كان عمرو بن سعيد الأشدق (60ـ61هـ/679ـ680م)([1494]) والياً على المدينة من قِبَل يزيد بن معاوية، وبُعث إليه برأس الحسين× بعد قتله، فكفّنه ودفنه في البقيع إلى جنب قبر أمّه فاطمة‘ بنت رسول الله’([1495])، ويُذكَر أنّه «لمّا أُوتي برأس الحسين له أعرض بوجهه عنه واستعظم أمره، فقال مروان لحامل الرأس: هاته، فدفعه إليه، فأخذه بيديه وتناول أرنبة أنفه وقال:
|
يا حبذا بردك في اليدينِ |
بينما أشار سبط بن الجوزي إلى أنّ الذي أخذ بأرنبة أنف الحسين× بعد أن وُضِع الرأس بين يديه هو والي المدينة عمرو بن سعيد([1497]).
واتّفق ابن تيمية مع مَن ذهب
إلى أنّ رأس الإمام الحسين× دُفِن في المدينة المنوّرة، واختلف معهم في مكان الدفن،
حيث أشار هو إلى دفن الرأس عند أخيه
لا عند أُمّه، معتمداً في ذلك على مَن يثق بهم من العلماء والمؤرِّخين حسب قوله([1498]).
وذكر النويري قولاً آخر في إرسال رأس الإمام الحسين× إلى المدينة، ولم يشر إلى قائله، بل ردّه إلى (القيل)، فقيل: أن الرأس أرسل إلى بني هاشم في المدينة، فأخذوه وغسّلوه وكفّنوه، وصلّوا عليه، ودفنوه عند قبر أمّه([1499]).
ويعتقد بعضهم بأنّ رأس
الإمام الحسين× دُفِن في البقيع تحت قبّة العباس
ابن عبد المطّلب([1500])، إلى
جانب الذين دُفِنوا في هذا المكان، وهم كل من الحسن
ابن علي بن أبي طالب، وابن أخيه علي بن الحسين، وابنه محمّد الباقر([1501])، وابنه
جعفر الصادق^([1502])، وقيل:
إنّ قبر السيّدة فاطمة‘ بنت النبي| موجود
تحت قبّة العباس أيضاً([1503]).
رابعاً: دفن رأس الإمام الحسين× في مرو خراسان
أشارت بعض الروايات إلى أنّه في رباط([1504]) خارج مدينة مرو، وعلى بعد فرسخين([1505]) منها، يوجد قبر صغير قيل: إنّ فيه رأس الحسين بن علي÷([1506])، وأكّد السمعاني دفن رأس الحسين× في مدينة مرو، وفي قصر من قصور المجوس فيها([1507])، على يمين الداخل تحت الجدار، وقد كُتِب عليه حديث[1508]).
كما أشارت روايات أخرى إلى أنّ بني العباس عند نجاح ثورتهم وقيام دولتهم وتقدّم جيشهم لفتح المدن، وعند وصوله إلى مدينة دمشق؛ سألوا عن موضع رأس الحسين×، فنبشوه وأخذوه معهم([1509]). وقيل: إنّهم وجدوا الرأس في خزائن سلاح بني أميّة، وإنّ أبا مسلم الخراساني([1510]) نقله إلى خراسان([1511]).
وتبالغ الروايات وتُشير إلى أنّ البرمكي([1512]) يقول: بأنّه قال له منصور بن طلحة ابن طاهر بن الحسين([1513]) في سنة 256هـ/869م، وهما في دار الإمارة بمرو: هل تريد رؤية رأس الحسين×، وعندما كان ردّه بالإيجاب، أمر منصور الغلمان بحفر موضع الرأس، حتى وصلوا إلى وهدة([1514])، ثمّ أخذ الآلة وواصل الحفر بنفسه، إلى أن وجد طاقاً([1515]) داخله سفط ففتحه، ووجد فيه رأساً محشوّاً بالمسك، وقطعة ملصقة على الرأس مكتوب عليها: رأس الحسين بن علي بن أبي طالب، وعندها غلب عليهما البكاء، وصلّيا عليه، ثمّ ردّ الرأس إلى مكانه([1516]).
خامساً: دفن رأس الإمام الحسين× في العراق
لقد أشارت بعض الروايات التاريخية إلى أنّ رأس الإمام الحسين× دُفِن في العراق دون أن تحدّد موضعاً بعينه، بل ذكرت في ذلك ثلاثة مواضع هي: الغري، والكوفة، وهذان الموضعان يقعان اليوم في محافظة النجف، ثمّ الموضع الثالث في الطفّ (كربلاء)، ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى مجموعتين هما:
1 ـ المجموعة الاولى الروايات القائلة بدفنه في النجف
لقد أشارت بعض الروايات إلى دفنه في الغري، ومنها:
عن يزيد بن عمر بن طلحة([1517])، قال: «قال لي أبو عبد الله (يعني جعفر الصادق)× وهو بالحيرة: أما تريد ما وعدتك؟ قلت بلى ـ يعني الذهاب إلى قبر أمير المؤمنين علي× ـ... فركب وركب ابنه إسماعيل وأنا، حتى إذا جاز الثوية([1518])، وكان بين الحيرة والنجف عند ذكوات([1519])بيض، نزل ونزل إسماعيل ونزلت، فصلّى وصلّى إسماعيل وصلّيت، فقال لإسماعيل: قم فسلّم على جدّك الحسين×، فقلت: جعلت فداك أليس الحسين بكربلاء؟ فقال: نعم، ولكن لمّا حُمِل رأسه إلى الشام سرقه مولى لنا، فدفنه بجنب أمير المؤمنين×»([1520]).
وقد ذكر يونس بن ظبيان([1521]) أنه كان في الحيرة مع جعفر الصادق× أيّام قدومه على أبي جعفر المنصور العباسي، وأنّه خرج معه من الحيرة، وقال له: «تقدّم يا يونس، قال يونس: فأقبل يقول الصادق: تيامن تياسر، فلمّا انتهينا إلى الذكوات الحمر قال الصادق: هو المكان، نعم، فتيامن، ثمّ قصد إلى موضع فيه ماء وعين فتوضأ الصادق، ثمّ دَنَا من أكمة([1522]) فصلّى عندها، ثمّ مال عليها وبكى، ثمّ مال إلى أكمة دونها ففعل مثل ذلك، ثمّ قال الصادق: يا يونس افعل مثل ما فعلت، ففعلت ذلك، فلمّا فرغت قال لي: يا يونس تعرف هذا المكان؟ فقلت: لا، فقال: الموضع الذي صلّيت عنده أولا هو قبر أمير المؤمنين ـ علي ـ ×، والأكمة الأخرى رأس الحسين بن علي بن أبي طالب×. إنّ الملعون عبيد الله بن زياد ـ لعنه الله ـ لما بعث برأس الحسين× إلى الشام رُدّ إلى الكوفة، فقال ابن زياد: أخرجوه عنها لا يُفتن به أهلها. فصيّره الله عند أمير المؤمنين علي×»([1523]).
وفي رواية أخرى: «إنّك إذا أتيت الغري رأيت قبرينِ، قبراً كبيراً، وقبراً صغيراً، فأمّا الكبير فقبر أمير المؤمنين×، وأمّا الصغير فرأس الحسين×»([1524]).
2 ـ المجموعة الثانية الروايات الدالّة على دفنه في الطفّ (كربلاء)
تذكر الروايات أنّ رأس الإمام الحسين× دُفِن في الطفّ (كربلاء)، إذ أُعيد إليها يوم العشرين من صفر مع علي بن الحسين (السجّاد)، عند رجوعه من الشام([1525])، ودُفِن مع جسد الحسين بعد أن طِيف به في البلاد([1526]). وفي رواية سبط بن الجوزي: ردّه يزيد بن معاوية إلى المدينة مع السبايا، ثمّ رُدّ إلى الجسد بكربلاء فدُفِن معه([1527]).
وأشارت رواية أخرى إلى أنّ رأس الإمام الحسين× أُعيد إلى الجسد في كربلاء، بعد أن مكث في خزائن السلاح الأموي إلى عهد سليمان بن عبد الملك (96ـ 99هـ/714ـ717م) الذي طلبه من الخزانة، وكفّنه ودفنه في إحدى مقابر المسلمين بدمشق، كما أشرنا آنفاً، ولمّا تولّى الحكم عمر بن عبد العزيز (99ـ101هـ /717ـ 719م)([1528])، بعث إلى خازن السلاح يطلب منه رأس الإمام الحسين×، فأخبره بما فعله سليمان بن عبد الملك في الرأس، فأمر بنبشه وأخذه، والله أعلم بما صنع به. والظاهر أنّ عمر بن عبد العزيز بعثه إلى الطفّ (كربلاء)، فدُفِن مع الجسد([1529]).
وأشار الباحث الإسلامي باقر شريف القرشي إلى أنّ رجوع الرأس إلى كربلاء ذكره العديد من علماء السنّة، بقوله: «كما اشتهر ذلك عند فريق كبير من علماء السنّة، منهم الشبراوي وابن الجوزي والبيروني والقزويني، وغيرهم»([1530]).
وعند الرجوع إلى مصنّفات هؤلاء وجدنا أنّ الشبراوي أشار إلى أنّ رأس الحسين أُعِيد إلى الجسد في الطفّ، بعد أربعين يوماً من قتله([1531]). ولم يشر ابن الجوزي إلى مثل ما نقله عنه القرشي، بل أشار إلى أنّ رأس الحسين وُجِد في خزانة يزيد، فأخرجوه وكفّنوه ودفنوه عند باب الفراديس في دمشق([1532]). وأشار البيروني إلى أنّ في العشرين من شهر صفر رُدّ رأس الحسين إلى جسده، ودُفِن معه([1533])، وتابعه القزويني في ذلك([1534])، وكان الصدوق قد أكّد قبل هؤلاء المؤرِّخين ـ آنفي الذكر ـ على أنّ رأس الحسين أُعِيد إلى الجسد ودُفِن معه([1535]).
ممّا تقدّم يتبيّن لنا وجود عدد كبير من الروايات المتشعّبة والمتداخلة، والتي تصل إلى حدّ التناقض أحياناً، دون حسم حادثة دفن رأس الحسين وتحديد موضعه، فضلاً عن العدد غير القليل الذي يراه النّاس من المشاهد والمزارات والمساجد التي تحمل اسم رأس الإمام الحسين×، أو مشهد الإمام الحسين×، أو مقام الرأس الشريف، أوموضعه.
وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مواقف السلطة الأموية ـ وعلى رأسها يزيد بن معاوية وتعامله مع السبايا والأسرى من آل البيت، وما يمكن أن يتّخذه من قرار بشأن رؤوس قتلى الطفّ التي بين يديه، أولها رأس الإمام الحسين× ـ لها الأثر الكبير في تحديد موضع دفنها، ولذلك نقل المؤرِّخون كثيراً من التحوّلات ـ التي تصل إلى حدّ التناقض ـ في مواقف يزيد ازاء أهل البيت، وإن كان كثير منها يُصنّف من قبيل النفاق السياسي والاجتماعي، وتلوّن الحكّام بحسب المستجدّات.
ومع ذلك فقد تكوّنت لدينا ملاحظات لكل موضع من المواضع التي أشارت إليها الروايات بأنّه محل دفن رأس الإمام الحسين×، والملاحظات هي:
1 ـ إنّ الروايات التي أشارت إلى أنّ رأس الإمام الحسين× دُفِن في دمشق في عهد يزيد أو بعد مماته، قد يكون ذلك بعد أن بلغ يزيد مآربه بقتل الحسين وأنصاره، ونفّس عن عقيدته في التشفّي منه في مجلسه، غير مكترث بما سمعه من ردود أفعال رافضة من بعض الصحابة الحضور في مجلسه، ومن أفراد من ذَوي الديانة اليهودية والنصرانية، وحتى من بعض أفراد أهل بيته وبني عمومته، فضلاً عن الخطب المؤثّرة للإمام علي بن الحسين÷ وعمّته السيّدة زينب بنت علي÷، وما أحدثته من أثر في الرأي العام وتحوّلاته الفكرية.
ولكنّ الروايات الواردة لما فيها من ضعف وتناقض واختلاف وتباين وطريقة عرضها للموضوع ؛ يضعّف هذا الاحتمال، وتجعلنا نشكّك في دفن رأس الإمام الحسين× في مكان ما في دمشق، فهي مرة تدفنه في بستان بدمشق، وتارة في دار إمارتها، وحيناً في أسطوانة في المسجد الجامع، وأخرى في مقبرة، ورابعةً في باب الفراديس، ومرّة يحتفظ به يزيد في خزانة السلاح، ثمّ الطامة الكبرى يدفن الرأس الشريف في قبر أبيه معاوية ليحصّنه بعد الممات، حسب قول يزيد نفسه، والتي تُظهر يزيد مظهر العارف بمكانة الإمام الحسين بن علي÷ وقدسيّته.
وبعض الروايات لا تُثبِت سوى وجود مشهد أو مسجد أو مقام، والمشهد أو المسجد قد يُقام على محلّ وُضع فيه الرأس الشريف، كما شيّد العديد منها في طريق السبي تبرّكاً به.
2 ـ إنّ احتمال بقاء رأس الحسين في خزانة السلاح في دمشق إلى عهد سليمان بن عبد الملك (96ـ99هـ/714ـ717م)، الذي أخرج الرأس الشريف من خزانة السلاح وكفّنه وصلّى عليه ودفنه؛ ليس بالأمر المستحيل، لدأب الحكّام الأمويين على الاحتفاظ برؤوس قتلى خصومهم([1536])، إلّا أنّ الروايات الواردة في ذلك لا تأخذ احتمالا إلى درجة الاعتبار؛ لعدم شهرتها، ونعتقد أنّها رواية أموية، وُضِعت لرفع مكانة سليمان بن عبد الملك، الذي زعم أنّه جاءه النبي في المنام ملاطفاً ومبشّراً له، وفي الصباح سأل سليمان بن عبد الملك الحسن البصري([1537]) عن ذلك، فكان جواب الأخير : لعلّك فعلتَ معروفاً لآل بيت النبي، فقصّ عليه سليمان ما فعله برأس الحسين ودفنه، وعندها ردّ الحسن على سليمان بأنّ رضى النبي عنك هو بسبب ما فعلته برأس الحسين؛ ولهذا أمر سليمان للحسن بجائزة سنية([1538]).
وبعد هذا يقوم عمر بن عبد العزيز (99ـ101هـ/717ـ719م) بالسؤال عن رأس الإمام الحسين×، وعند إخباره بما فعله ابن عمّه سليمان بن عبد الملك من دفنه للرأس؛ أمر بنبشه وإرساله إلى الطفّ (كربلاء) لدفنه مع الجسد. فهل فعل نبش القبور عمل يقرّه الإسلام؟! وترجع الروايات مرّة أخرى إلى أنّ رأس الإمام الحسين× استخرجه القائد الأموي منصور بن جمهور من خزانة السلاح ودفنه، وكان ذلك إبّان أحداث الصراع على السلطة بين أولاد العم، الوليد بن يزيد ويزيد بن الوليد سنة 126هـ/744م، فإن صحّت هذه الروايات فإنّها تشير إلى رفض فعل بني أميّة من بني أميّة أنفسهم وبعض أعوانهم.
3 ـ أمّا الروايات التي أشارت إلى دفن رأس الإمام الحسين× في الرقّة، فمن غير المستبعد أن يبعث يزيد بن معاوية رأس الإمام الحسين× إلى أقربائه من بني أميّة؛ ليشاركوه أفراحه واحتفالاته، باعتباره أخذ بثأرهم من أعدائهم ـ كما يعتقدون ـ ومن باب إرهاب النّاس أيضا.
مع ذلك لا يمكن قبول دفن الرأس في الرقّة بسهولة؛ لأنّ هذه الرواية مرسلة، وليس فيها أيّ سند حتى يمكن الوثوق بها واعتمادها؛ إذ إنّ سبط بن الجوزي قد رواها من كتاب مقتل الحسين، لمصنّفه عبد الله بن عمرو الوراق(ت274هـ/ 887م)، الذي يُعدّ من المصنّفات الضائعة، وإنّ هذه الرواية لم تذكر في أيّ من المصادر المتقدّمة؛ لذا لا يمكن الأخذ بها.
4 ـ أما الروايات التي أشارت إلى أنّ رأس الإمام الحسين× دُفِن في عسقلان فالأمر فيه غاية الإشكال؛ فمن جهة لا يوجد نصّ صريح في المصادر المتقدّمة يدلّ على أنّ رأس الحسين دُفِن في عسقلان أو نقل إليها من الشام، وما ذكر في بعض المصنّفات المتأخّرة يعتمد على وجود مشهد للإمام الحسين× في عسقلان، ولكنّ عمارة وتشييد هذا المشهد متأخّرة جداً عن وقت قتل الإمام الحسين×، وجزم ابن تيمية بأنّ المشهد في عسقلان ليس لرأس الإمام الحسين×، وإنّما هو قبر لأحد النصارى أو لأحد الحواريين([1539])، وكذلك نفى النويري دفن رأس الإمام الحسين× في عسقلان أو مصر([1540]).
ثمّ إنّ المتتبّع لسير الأحداث في دمشق منذ وصول السبايا إليها وحتى رجوعهم إلى المدينة المنوّرة، لا يجد ما يؤكّد حصول مثل هذا الأمر، خصوصا وأنّ فترة بقاء أهل البيت في دمشق كانت قصيرة، لأنّ يزيد عجّل بإخراجهم؛ حفاظاً على ملكه، وخشية من تطوّر الأحداث.
5 ـ أمّا الروايات التي أشارت إلى نقل رأس الإمام الحسين× إلى مصر ودفنه في القاهرة، فإنّ أول مَن نفى هذا الأمر هو ابن تيمية، فقد أكّد على عدم وجود الرأس في القاهرة، ووصف ذلك بقوله: «ما هو إلّا كذب واختلاق وافك وبهتان»([1541])، وتابعه تلميذه ابن كثير في نفيه وجود الرأس في القاهرة، وأتّهم الفاطميّين بأنّهم افتروا ذلك؛ لأنّهم «أرادوا أن يُروّجوا بذلك بطلان ما أدّعوه من النسب الشريف، وهم في ذلك كذبة خؤونة»([1542]). ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ وجود الرأس من عدمه في القاهرة لا علاقة له بنسب الفاطميّين([1543]) بأيّ حال من الأحوال، وحتى لو كان يمنحهم بعض الشرعية، إذ كان الأولى أن يقوموا بنقل الرأس في أيّام المستنصر بالله الفاطمي (427ـ487هـ /1035ـ1094م)([1544]) عقب اكتشافهم المرقد مباشرةً، وليس في أواخر عهد دولتهم وفي أضعف أيّامها وأكثرها خوفاً من وقوعها في يد الصليبيين، ولو كان ثمّة شرعية تتحقّق للفاطميّين بوجود رأس الإمام الحسين× بالقاهرة ـ كما يردّد ابن كثير ـ لعمل الفاطميّون على نقل أجساد أئمّة أهل البيت الموجودين في العراق، عندما أصبح العراق كلّه تحت الحكم الفاطمي لمدّة عام كامل([1545])، ويبدو أنّ ابن كثير في نفيه هذا يتّفق مع شيخه ابن تيمية([1546]).
كما يُلاحظ التناقض بين روايتي القلقشندي والمقريزي، ففي الوقت الذي أشار فيه القلقشندي بأنّ رأس الإمام الحسين× تمّ نقله خوفاً من أن تقع عسقلان بأيدي الفرنجة سنة 549هـ/1154م([1547])، نجد المقريزي يشير إلى أنّ الفاطميّين افتدوا رأس الإمام الحسين× بمال كثير عند سقوط عسقلان بأيدي الفرنجة سنة 548هـ/1153م([1548]).
ومن الجدير بالذكر أنّ الباحث المعاصر الدكتور هادي عبد النبي التميمي ـ وهو يعدّ دراسته لنيل شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي في كلية الآداب بجامعة الكوفة ـ ذكر أنّه زار القاهرة، وعلم أنّ هناك دراسة تقدّم بها أحد الباحثين إلى الأزهر الشريف أراد فيها إثبات عدم دفن رأس الإمام الحسين× في القاهرة، لكنها رُفِضت، وعُنِّف هذا الباحث لتوجّهه هذا؛ لأنّه يضرّ بمصالح البلاد الاقتصادية، لأنّ مشهد الرأس يدرّ على البلاد موارد مالية لا يُستهان بها كموقع أثري وسياحي، وإنّ الباحث التميمي وجد الدكتور المصري محمود إسماعيل عبد الرزّاق في لقاء معه في داره التي تقع بالمنصورة بتاريخ 13/مايس/2005م، وهو يتبنّى الرأي الذي يذهب إلى عدم وجود رأس الإمام الحسين× في القاهرة؛ لتأثّره بتلك الدراسة التي لم يفصح عن عنوانها ولا عن اسم الباحث الذي أعدّها([1549])، ومع ذلك فإنّ هناك عدداً من الباحثين المصريين يُؤكّدون على وجود رأس الإمام الحسين× مدفوناً في القاهرة([1550]).
6 ـ أمّا الروايات التي أشارت إلى دفن رأس الإمام الحسين× في بقيع المدينة المنوّرة، فانّ أغلبها ذهب إلى أنّه دُفِن عند قبر أمّه فاطمة‘ بنت النبي محمّد’.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل أنّ قبر فاطمة‘ كان معلوماً لدى الخاصّة والعامّة من النّاس حتى يُدفن رأس ولدها الإمام الحسين× إلى جانب قبرها؟ فالمعروف أنّ السيّدة فاطمة‘ أوصت قبل مماتها بعدم تعريف أحد بمكان قبرها بعد الممات، فلمّا تُوفِّيت جهّزها ودفنها سرّاً زوجها الإمام علي بن أبي طالب× ومعه ولداه الحسن والحسين÷، وقيل: معه نفر من بني هاشم وعدد من الصحابة. وسوّى حواليها عدداً من قبور مزوّرة حتى لا يُعرف قبرها([1551]). وقيل: إنّها دُفِنت ليلاً في دارها التي أدخلها عمر بن عبد العزيز (99 ـ 101هـ/717 ـ 719م) في المسجد النبوي، وبالتالي فكثير من الناس لم يعلم مكان دفنها([1552]).
وهنا لا بدّ من التساؤل: إذا كان العدد الذي ذُكِر حضر موعد دفنها فكيف لم يعرف مكان قبرها؟! ألم يصرّح أحدهم بمكانه ولو بعد حين؟! ما يبدو أنّ الدفن أُنجِز بمنتهى السرّيّة، وحافظ كلّ مَن حضره وعلى قلّتهم على سرّيّته؛ إلتزاماً بوصيّتها، لذا نعتقد بعدم صحّة رواية دفن رأس الإمام الحسين× إلى جنب قبر أمّه. وما يُؤكّد هذا أنّ الرحالة ابن جبير زار المدينة المنوّرة سنة 578هـ/1182م، وذكر المراقد الموجودة في البقيع، ولم يشر إلى وجود رأس الإمام الحسين× هناك رغم ذكره لكلّ مراقد آل البيت^([1553])، كذلك أنّ الرأس لم يشتهر وجوده في بقيع المدينة المنوّرة، سواء أكان بالقرب من قبر أمّه أم من قبر أخيه.
7 ـ أمّا احتمال دفن رأس الإمام الحسين× في مرو في خراسان فلا يمكن الأخذ به؛ لعدم شهرته، وبُعدُ وقوعه، ولو أنّ بني العباس نقلوا الرأس لكانت حادثة مشهورة، ولتناولتها المصادر المتقدّمة. ثمّ إنّ الأولى ببني العباس إذا عنوا بنقل رأس الإمام الحسين× من دمشق، لنقلوه إلى الطفّ (كربلاء)، ودفنوه مع جسده.
كما أنّ الملاحظ على رواية الجغرافي المقدسي ـ التي أشار فيها إلى دفن رأس الإمام الحسين× في مدينة مرو ـ قد أخذها من النّاس الذين قالوا له بذلك عندما رأى رباطاً خارج المدينة. بينما أشار السمعاني إلى دفن رأس الإمام الحسين× معتمداً على ما وجده من كتابة على جدار بناية القبر تشير إلى ذلك، ولا يوجد سند تاريخي يؤكّد دفن الرأس في مرو.
أمّا الروايات التي ذكرت بأنّ أبا مسلم الخراساني هو الذي نقل الرأس إلى خراسان، فهذا بعيد جداً؛ وذلك لأنّ أبا مسلم لمّا فُتِحت الشام كان بخراسان، والذي فتح دمشق عبد اللَّه بن علي([1554]) بن عبد الله بن العباس([1555])، فكيف يُتَصوّر أن يتمكّن من نقله إلى خراسان؟! ولو ظفر بالرأس في خزائن بني أميّة، أو في أيّ مكان آخر، لأظهره للناس؛ ليزدادوا لبنى أميّة بغضاً وكراهيةً([1556]). ثمّ إنّ الروايات التي أشرنا إليها سابقاً، ذكرت أنّ رأس الحسين أُخرِج من خزانة السلاح الأموي، مرّة في عهد سليمان بن عبد الملك (96ـ99هـ/714ـ717م)، الذي كفّنه ودفنه، ومرّة أخرجه منصور بن جمهور سنة 126هـ/744م، ودفنه في إحدى المقابر بدمشق.
أمّا الرواية التي أشارت إلى رؤية الرأس في دار الإمارة بمرو، فهي تتعارض مع تلك الرواية التي تذهب إلى أنّ الرأس مدفون في رباط يبعد فرسخينِ عن مدينة مرو، فكيف وُجِد الرأس مدفوناً في دار الأمارة؟! وبهذا يمكن القول بعدم الأخذ بجميع الروايات التي تشير إلى دفن رأس الإمام الحسين× في مرو خراسان.
8 ـ أمّا الروايات الدالّة
على دفن الرأس في الغري (النجف)، فيُلاحظ عليها
ما يلي:
1 ـ إنّ الروايات التي جاءت عن الإمام الصادق×، والتي أشارت إلى دفن رأس الإمام الحسين× في الغري عند قبر أبيه الإمام علي بن أبي طالب×؛ هي إمّا أن يكون رواتها مجهولين، أو غير ثقات. فرواية يزيد بن عمر بن طلحة لا يمكن الأخذ بها لأنّ رواتها من المجاهيل([1557])، ولم يُنقَل عن الإمام الصادق× سوى هذه الرواية التي أشارت إلى أنّ الذي جاء برأس الإمام الحسين× أحد موالي أهل البيت بعد سرقته، وذلك عندما أُرسل الرأس إلى الشام، وقام بدفنه إلى جنب قبر الإمام علي×، وهذا لا يمكن أن يحدث لعدّة أسباب:
السبب الأول: إنّ رأس الإمام الحسين× عند إرساله إلى الشام أُحيط بحراسة مشدّدة كُلِّف بها أربعون جندياً ـ وفقاً لرواية ابن نما الحلي([1558]) ـ فكيف يمكن سرقة الرأس وقد أُحيط بهذا العدد من الجند لحراسته؟!
السبب الثاني: إنّ العديد من الروايات ذكرت بأنّ الرأس الشريف وصل إلى يزيد بن معاوية في دمشق، وفعل به ما فعل من ضربٍ وطوافٍ وصلب في الشام، ولو أنّه كان قد سُرِق لَذُكِر هذا الأمر في المصادر التاريخية المتقدّمة.
السبب الثالث: إنّ قبر الإمام علي بن أبي طالب× ظلّ مخفيّاً إلى أن اكتُشِف من قِبَل هارون العباسي (170 ـ 193هـ/786 ـ 808م)، وذلك في العام الأوّل من توليّه الحكم، حيث أمر ببناء ضريح للقبر تعلوه قبّة، ومن ثمّ توالى البناء في السنوات المتعاقبة، وأخذ النّاس بزيارته ودفن موتاهم حوله([1559])، فكيف عُرِف قبر الإمام علي ابن أبي طالب× قبل هذه الفترة المبكرة عن تاريخ كشف القبر حتى يُقالبدفن رأس ولده الإمام الحسين× إلى جانبه؟! ومَن هو هذا الرجل الموالي لآل البيت الذي يحتفظ بمعرفته مكان القبر؟ وهل انفرد هذا الرجل بذلك دون غيره من الموالين لآل البيت وهم كُثُر؟!
أمّا رواية يونس بن ظبيان
فلا يمكن الوثوق بها؛ لأنّ علماء الجرح والتعديل ضعّفوا رواياته، وأشاروا إلى أنّ
كلّ كتبه تخليط([1560])، وأنّه
كذّاب بحيث ادّعى
أنّ الله تعالى كلّمه، حيث قال: «كنتُ في
بعض الليالي وأنا في الطواف، فإذا نداء من فوق رأسي: يا يونس إنّي أنا الله، لا
اله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري»، وعندما
أُخبِر علي بن موسى الرضا×([1561]) بهذا
الحديث غضب على يونس بن ظبيان ولعنه([1562]). وقال
عنه أبو القاسم الخوئي في تعليقه على هذه الرواية: «هذه
الرواية صحيحة السند، ودالّة على خُبث يونس بن ظبيان وضلاله»([1563]). ومن هذا
يتبيّن بأنّه لا يمكن الأخذ بروايته.
أمّا ما ذكره يونس بن ظبيان من أن ابن زياد دفن الرأس خارج الكوفة عندما ردّه إليه يزيد، فقد علّق عليها بعض الباحثين بقولهم: «يصعب القبول بهذه الرواية؛ لأنّ المعروف أنّ مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف لم يُكتَشف إلّا بعد سقوط الدولة الأموية، وبالتالي فإنّ دوافع الدفن بالنجف تبدو معدومة لعبيد الله بن زياد، حيث إنّه لا يعلم بوجود قبر في هذا المكان»([1564])، وأكّدت على عدم صحّة هذه الرواية الباحثة المصرية سعاد ماهر بقولها: «من أنّ هذا قول مرسل، لا يقوم على سند ولا دليل»([1565]).
وأما الروايات التي ذكرها الكليني([1566])، وابن قولويه([1567])، والطوسي([1568])، والمشهدي([1569])، والعاملي الشهيد الأول([1570])؛ فإنّها أشارت إلى أنّ مكان رأس الإمام الحسين× الموجود في النجف هو موضع للرأس، وليس مكان دفنه.
إنّ الذي جعل البعض يعتقدون بدفن رأس الإمام الحسين× في النجف، هو ما جاء عن الإمام الصادق×من روايات، تحتاج إلى وقفة نظر وتأمّل؛ بسبب ضعفها، أو أنّ رواتها مجهولون، أو غير ثقة، وإنّ الموضع الذي يقع في الكوفة دُفِن فيه ما تبقّى من رأس الإمام الحسين× بعد التقوير، حيث «قام عمرو بن حريث المخزومي فقال: يا ابن زياد قد بلغت حاجتك من هذا الرأس، فهب لي ما ألقيتَ منه، فقال: ما تصنع به؟ فقال عمرو: أواريه، فقال: خذه، فجمعه في مطرف خزّ كان عليه، وحمله إلى داره، فغسّله وطيّبه وكفّنه ودفنه عنده في داره، وهي بالكوفة، تُعرف بدار الخزّ، دار عمرو بن حريث المخزومي»([1571]). ولعلّ هذا الأمر هو الذي جعل البعض يختلط عليهم الأمر ويعتقد بأنّه مكان دفن الرأس. ومن هنا يتبيّن أنّ أيّاً من الموضعيِن سواء في الغري أم في الكوفة، ليسا مكاناً لدفن رأس الإمام الحسين×.
وخلاصة القول: إنّ عملية قطع رؤوس القتلى بعد موتهم هي ثقافة أموية، صارت ظاهرة سياسية انتهجها بنو أميّة دون خشية أحد أو حياء منه، دلّت على بربريّتهم، وعدم تخلّصهم من الرواسب الجاهلية منذ وقت مبكّر من تولّيهم السلطة، واستعملت هذه الظاهرة مع الأفراد والجماعات التي لها تأثير سياسي أو قَبَلي، فقد تمّ قطع رأس محمّد بن أبي بكر والي مصر للإمام علي بن أبي طالب× سنة 38هـ/658م، وقطع رأس الصحابي عمرو بن الحمق الخزاعي سنة 51هـ/671م، وإرسال رأسيهما إلى معاوية بن أبي سفيان بدمشق حاضرة الحكم الأموي، وكذلك قُطِعت رؤوس المؤيّدين لثورة الإمام الحسين بن علي÷ في الكوفة من قِبَل ابن زياد الوالي الأموي، الذي اختار من أمثال مسلم بن عقيل ابن عمّ الإمام الحسين× ورسوله إلى أهل الكوفة، وهانئ بن عروة رئيس قبيلة مذحج، حيث قام ابن زياد بقطع رأسيهما بعد قتلهما وإرسالهما إلى يزيد بن معاوية بدمشق أيضا، بينما لم يرسل رؤوس قتلى آخرين؛ لعدم تأثيرهم السياسي والقَبَلي، فضلاً عن الأوامر التي صدرت من ابن زياد إلى قائد الجيش الأموي المحارب للإمام الحسين× وأنصاره في الطفّ بقطع رؤوس القتلى، وبلغت أكثر من سبعين رأساً، وأُرسِلت إلى الكوفة، ثمّ أرسلها ابن زياد إلى دمشق، بعد أن أستبعدت رؤوس قتلى أنصار الإمام الحسين× من غير الهاشميين؛ لتدخّل قبائلهم لدى ابن زياد وطلبها منه بردّ الرؤوس إليهم، ويبدو أنّ ابن زياد لم يتوانَ عن ذلك، وكان يبغي الهدوء واستتاب الأمن في الكوفة. وتمّ استعراض رؤوس القتلى في الكوفة وفي مدن وقرى الطريق إلى الشام، وأخيراً في شوارع دمشق وأسواقها، وإدخالها على يزيد بن معاوية في مجلسه العام بصحبة سبايا آل البيت.
إنّ من بين المواضيع التي اختلف فيها المؤرِّخون هي تحديد موضع دفن رأس الإمام الحسين×، وإنّ كثرة الأماكن التي ظهرت هنا وهناك، والتي ادُّعي بأنّها الموضع الذي دفن فيه الرأس الشريف؛ لما له من مكانة كبيرة، وقدسية في قلوب المسلمين بصورة عامّة، وكذلك بسبب التضحية العظيمة التي قدّمها الحسين×.
ونعتقد بوجود حكمة إلهية في كثرة المواضع التي ادُّعي أنّها ضمّت رأس الإمام الحسين×؛ ليضيع موضع الرأس بين هذا العدد الكبير من الأماكن وأماكن أخرى وضع عليها الرأس، أو أنّ قطرة من دمه سقطت فيها، فبُنِيت عليها المساجد، أو المقامات، أو المشاهد، لتظلّ صوتاً مدوّياً في كلّ العصور، رافضاً للظلم وأعوانه، والفساد وأصحابه. وكلّ ذلك من أجل أن يبقى أثر الجريمة الكبرى بحقّ أهل البيت ^، التي ارتكبها يزيد بن معاوية وأعوانه، ولمنع كلّ الأقلام المأجورة التي تحاول نفي هذه الجريمة عنه، أو تبرّؤه منها، وإن كانت الروايات أشارت إلى عدّة مواضع دُفِن فيها رأس الإمام الحسين×، سواء بدمشق أم بالرقّة، أو بعسقلان، أو بمصر، أو دفن في بقيع المدينة المنوّرة، أو في مرو خراسان، أو في الطفّ (كربلاء)، وهذا ما نميل إليه، وعبّرت عنه أكثر من رواية، فضلاً عن حفظ ذاكرة الموروث الشعبي الذي تناقلته الأجيال من جيل إلى آخر، فستظلّ ذكراه لتضحيّته وأهل بيته وأنصاره أنيناً يبيّن عظم الرزية التي تُخيّم على القلوب المتعلّقة بحبّ الإمام الحسين×، وشعاعاً يُنير ظلمات الدروب، وفكراً وهّاجاً يرسم عيش الحياة بحرية، وعزّة ملؤها الأمل الكريم، وبسمة لروح طفولةٍ في وسط دموع حزنٍ غاضب، فإنّ ثورته سيغرف منها كلّ أحرار العالم التوّاقون إلى الحرية والسلام والأمان.
بعد هذه الرحلة المضنية في البحث والدراسة، متنقّلين بين الروايات التاريخية في مصادرها الأولية والثانوية تمحيصاً ووصفاً وإحصاءاً وتحليلاً واستنتاجاً، في موضوع دراستنا الموسوم بـ«سبي آل البيت^ من الطفّ إلى بلاد الشام دراسة تاريخية»؛ خلُصنا إلى عدد من النتائج، يمكن إدراجها بما يلي:
1ـ لم تعطِ بعض المصادر التاريخية التي اطّلعنا عليها رأيّاً واضحاً عن عدد آل البيت من الرجال والنساء والأطفال، الذين وقعوا في الأسر والسبي بعد قتل الإمام الحسين× ورجال بيته وأنصاره، ولكن يمكن أن نخمّن عدد ذلك من خلال ما عرفناه من الروايات، التي أشارت إلى عدد مَن خرج مع الإمام الحسين× من المدينة أثناء توجّهه إلى العراق، وهم جلّ أهل بيته من الرجال والنساء، من أولاده وبناته وأخواته وزوجاته وإخوته، وبعض أبنائهم وبناتهم ونسائهم، وبني عمومته من أولاد عقيل وجعفر وأبنائهم وبناتهم ونسائهم، فضلاً عن الأطفال والجواري.
وبعد قتل مَن قُتِل في معركة الطفّ من بني طالب وقع الأسر على اثني عشر غلاماً من غلمان بني طالب، وعلى الإمام علي بن الحسين÷، وعلى سبع وخمسين امرأة من نساء بني طالب، ومَن كان معهنّ من الجواري. ولم تسجّل الروايات قتل امرأة طالبية من بني طالب.
2ـ إنّ الهدف الذي كان يبغيه بنو أميّة وأعوانهم من سبي آل البيت^، واستعراضهم في شوارع المدن وأسواقها كما جرى في الكوفة ودمشق، ثمّ في طريق أطالوا مسافته عمداً عند نقلهم من الكوفة إلى دمشق تتفرّج عليهم حشود النّاس من شتّى الأهواء والنحل؛ هو التشهير بآل البيت، وذلك من خلال الاعتبارات التي كان يتوخّاها يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد، من برمجة الماكنة الإعلامية الأموية بأنّ الإمام الحسين× خارجي خرج عن طاعة أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، وأنّه أراد شقّ صفّ المسلمين ووحدتهم، وردّاً على ذلك لا بدّ من إعطاء درس وعبرة، وإدخال الخوف والرعب في نفوس كلّ مَن يريد الخروج من الثائرين على السلطة الأموية، فيكون حاله كحال الإمام الحسين× من القتل وعائلته من السبي مع أنّه سبط النبي، فاردوا من خلال ذلك بيان عدم قدسيّتهم لأي شخصية تريد مواجهة ظلمهم، وأنّهم عازمون على سحق كلّ ثورة تهدف لإسقاطهم واسقاط ظلمهم وفسادهم.
3. لقد كانت خُطب آل البيت^ ـ مع ما اتّصفت به تلك الخُطب من بلاغة وفصاحة وبيان ـ تُحاكي العقول والنفوس؛ لأنّها عبّرت عن شجاعتهم وجهادهم. كما تُعدّ هذه الخُطب وثائق سياسية وتاريخية وفكرية بيّنت أحداث تلك المرحلة، وساهمت في استمرار الثورة الحسينية؛ لما ترتّب عليها من أثر واضح وكبير في تغيير الرأي العام، سواء في الكوفة أم دمشق، بعد أن فضحت أفعال بني أميّة الشنيعة، ودحضت دعايتهم الإعلامية الكاذبة القائلة بأنّ الإمام الحسين× خارجي خرج على السلطة الشرعية، فعرّف النّاس حقائق الأمور، وأن الإمام× ليس خارجياً، بل إماما ثائرا ضد ظلم بني أميّة ومفاسدهم.
وقد ركّزت الخُطب في الكوفة على تحميل أهلها المسؤولية الكاملة عن فاجعة قتل الإمام الحسين×؛ لإعانتهم ابن زياد على ذلك، وتنصّلهم من العهود التي أعطوها للحسين بعد مطالبته بالقدوم عليهم وقيادته الثورة ضد بني أميّة. فوصفتهم تلك الخُطب بكلمات الذلّ والتوبيخ والتقريع، وبذلك أدّت إلى تصحيح الانحرافات الفكرية، وحوّلت الفرد الكوفي المتفرّج والمُكتفي بالبكاء إلى أن يراجع مواقفه ويلملمّها، ممّا مهّد إلى قيام حركة التوابين، وحركة المختار بن أبي عبيد الثقفي على التوالي ضد الأمويين.
واتّبعت الخُطب في دمشق اسلوباً واعياً دمّرت جبروت الطاغية، وألحقت به الهزيمة والعار، وبيّنت له أنّ دعاة الحقّ وعلى قلّتهم لا تنحني رؤوسهم أمام طغاة الباطل على كثرتهم، وفصّلت في كثير من الحقائق التاريخية التي كانت غائبة عن أذهان أهل الشام؛ بسبب تضليل الماكنة الإعلامية الأموية التي أسّسها معاوية بن أبي سفيان منذ تولّيه ولاية الشام.
وكانت ردود علي بن الحسين÷ وعمّته السيّدة زينب بنت علي÷ على عبيد الله بن زياد بمجلسه في الكوفة، ويزيد بن معاوية بمجلسه في دمشق، قد وضعتهما (ابن زياد ويزيد) في زاوية حرجة؛ لخيبتهما بفضحهما أمام النّاس، ممّا جعل ابن زياد يعجّل في إخراج سبايا آل البيت^ من الكوفة، وكذلك جعل يزيد يعجّل بخروجهم من الشام.
4ـ لقد أُقِيم المأتم على الحسين بن علي÷ منذ اليوم الثاني على قتله، فقد رثته أخته السيّدة زينب‘ عند مرور السبايا على أجساد القتلى المتناثرة على أرض الطفّ، حيث رفعت صوتها حزيناً شجيّاً، تنادي جدّها وأباها وبقية أهلها، تعرّفهم بما جرى على الإمام الحسين×. واستمرّت مثل هذه المرثيّات بشكل متكرّر في مدن طريق السبي بين الكوفة والشام، تارة على لسان علي بن الحسين÷، وتارة أخرى على لسان السيّدة زينب وأمّ كلثوم بنات علي بن أبي طالب×. كما أُقِيمت المآتم على الإمام الحسين× في بيوت قتلته؛ إذ عُقِد مأتم في سجن الكوفة الذي أودعهم فيه ابن زياد، من أول الليل حتى الفجر، وحضرته نساء الكوفة، وأُقِيم المأتم أيضا في بيت يزيد بن معاوية بدمشق لمدّة ثلاثة أيّام، حضرته نساء بني أميّة، أمثال عاتكة بنت يزيد وهند زوجته.
إنّ إقامة هذه المآتم ـ ومن أقرب المقرّبين لأصحاب القرار الأموي ـ يُعدّ رفضاً لما جرى على آل البيت^. ثمّ إنّ ما يُقال من مراثي يُعدّ وسيلة وجدانية، تعرّف العامّة من النّاس بما جرى على آل البيت أيضا.
5ـ لقد عانى سبايا آل البيت^ كثيراً من مدّة السبي، التي استغرقت حوالي شهر. ويمكن أن نقسّمها ما بين بقائهم في الكوفة ثلاثة أيّام، ومسيرهم في طريق السبي من الكوفة إلى بلاد الشام خمسة عشر أو ستّة عشر يوماً، وبقائهم في دمشق عشرة أيّام أقلّ أو أكثر قليلاً، ومرورهم على كربلاء، ومن ثمّ رجوعهم إلى المدينة المنوّرة.
الملاحق
ملحق رقم(1)
خطبة السيّدة زينب بنت علي÷ في أهل الكوفة
«الحمدُ لله والصلاة على أبي محمّد، وآله الطيّبين الأخيار، أمّا بعد: يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر أتبكون وتنتحبون؟! فلا رقأت الدمعة، ولا هدأت الرنّة، إنّما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً، تتّخذون أيمانكم دخلاً بينكم، ألا وهل فيكم إلّا الصلف النّطف، والصدر الشنف، وملق الإماء، وغمز الأعداء، أو كمرعى على دمنة، أو كفضة على ملحودة، ألا ساء ما قدّمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون، أتبكون وتنتحبون؟! أي والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولم ترحضوها بغسل بعدها أبداً، وأنّى ترحضون قتل سليل خاتم النبوّة، ومعدن الرسالة، وسيّد شباب أهل الجنّة، وملاذ خيرتكم، ومفزع نازلتكم، ومنار حجّتكم، ومدرة سنّتكم، ألا ساء ما تزرون، وبعداً وسحقاً فلقد خاب السعي وتبّت الأيدي، وخسرت الصفقة، وبُؤتم بغضب من الله، وضُرِبت عليكم الذلّة والمسكنة، ويلكم يا أهل الكوفة، أتدرون أيّ كبد لرسول الله فريتم؟! وأيّ كريمة له أبرزتم؟! وأيّ دم له سفكتم؟! وأيّ حرمة له انتهكتم؟! لقد جئتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقماء خرقاء شوهاء، كطلاع الأرض، أو كملء السماء، فأعجبتم أن مطرت السماء دماً، ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تُنصرون، فلا يستخفنّكم المهل، فإنّه لا يحفزه البدار، ولا يخاف فوت الثأر،(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)»([1572]).
وفي رواية الخوارزمي ختمت السيّدة زينب‘ خطبتها بعد قولها: (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ)، بقولها: «فترقّبوا أوّل النحل وآخر الصاد»([1573]).
ملحق رقم(2)
خطبة السيّدة زينب بنت علي÷ في الشام
«الحمدُ لله ربّ العالمين، والسلام على سيّد المرسلين، صدق الله تعالى إذ يقول:(ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ)([1574]).
أظننتَ يا يزيدُ حين أخذتَ علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، وأصبحنا نُساق كما تُساق الأُسارى، أنّ بنا على الله هواناً وبك عليه كرامة، وأنّ ذلك لعظم خطرك عنده؟! فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسروراً، حين رأيتَ الدنيا لك مُستوسقة والأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا، فمهلاً مهلاً! أنسيتَ قول الله تعالى:(وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ)([1575]). أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله سبايا؟! قد هتكت ستورهنّ، وأبديت وجوههنّ، يُحدى بهنّ من بلد إلى بلد، ويستشرفهنّ أهل المناهل والمناقل، ويتصفّح وجوههنّ القريب والبعيد، والدنيُّ والشريف، ليس معهنّ من رجالهنّ وليّ، ولا من حماتهنّ حميّ. وكيف تُرجى المراقبة ممَّن لفظ فوه أكباد السعداء، ونبت لحمه بدماء الشهداء؟! وكيف يُستبطأ في بغضنا أهل البيت مَن نظر إلينا بالشنف والشنئان والإحن والاضغان؟! ثمّ يقول غير متأثمّ ولا مستعظم:
|
فأهلّوا وأستهلّوا فرحاً |
منحنياً على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة، واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذريّة آل محمّد، ونجوم الأرض من آل عبد المطّلب! أتهتف بأشياخك؟! زعمت تناديهم، فلتردنّ وشيكاً موردهم، ولتودنّ أنّك شللتَ وبكمت، ولم تكن قلتَ ما قلتَ، اللهمَّ خذ بحقّنا، وانتقم ممّن ظلمنا، واحلل غضبك بمَن سفك دماءنا وقتل حُماتنا، فوالله ما فريتَ إلّا جلدك، ولا جزرتَ إلّا لحمك، ولتردَنّ على رسول الله بما تحمّلت من سفك دماء ذريّته، وانتهاك حرمته في لحمته وعترته، وليخاصمنّك حيث يجمع الله تعالى شملهم، ويلمّ شعثهم، ويأخذ لهم بحقّهم، (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) ([1576])، فحسبك بالله حاكماً، وبمحمّد خصماً، وبجبرئيل ظهيراً، وسيعلم مَن سوّل لك ومكّنك من رقاب المسلمين أن (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا)([1577])، وأيّكم(شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا)([1578]). ولئن جرّت عليّ الدواهي مخاطبتك، فإنّي لأستصغر قدرك، وأستعظم تقريعك، واستكبر توبيخك، لكن العيون عبرى، والصدور حرّى، ألا فالعجب كلّ العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، فتلك الأيدي تنطف من دمائنا، وتلك الأفواه تتحلّب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل، وتعفوها الذئاب، وتؤمّها الفراعل. فلئن اتّخذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً مغرماً، حين لا تجد إلّا ما قدّمت يداك، (وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)([1579])، فإلى الله المشتكى، وعليه المعوّل، فكد كيدك، واسعَ سعيك، وناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا، ولا تُمِيت وحينا، ولا تُدرك أمدنا، ولا ترحض عنك عارها، ولا تغيب منك شنارها، فهل رأيك إلّا فند! وأيامك إلّا عدد! وشملك إلّا بدد! يوم ينادي المنادي: (أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ)([1580]). فالحمد لله الذي ختم لأوّلنا بالسعادة والرحمة، ولآخرنا بالشهادة والمغفرة، وأسأل الله أن يكمل لهم الثواب، ويُوجب لهم المزيد وحسن المآب، ويختم بنا الشرافة، إنّه رحيم ودود، (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)([1581])، (نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ)([1582])»([1583]).
ملحق رقم (3)
خطبة الإمام علي بن الحسين÷ في الشام
«أيّها النّاس، أُعطينا ستّاً وفضّلنا بسبع، أُعطينا العلم، والحلم، والسماحة، والفصاحة، والشجاعة، والمحبّة في قلوب المؤمنين، وفضّلنا بأنّ منّا النبي المختار محمّداً، ومنّا الصدّيق، ومنّا الطيّار، ومنّا أسد الله وأسد الرسول، ومنّا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول، ومنّا سبطا هذه الأمّة وسيّدا شباب أهل الجنّة. فمَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكّة ومِنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن مَن حمل الركن بأطراف الردا، أنا ابن خير مَن ائتزر وارتدى، أنا ابن خير مَن انتعل واحتفى، أنا ابن خير مَن طاف وسعى، أنا ابن خير مَن حجّ ولبّى، أنا ابن مَن حُمل على البراق في الهوا، أنا ابن مَن أُسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فسبحان مَن أسرى، أنا ابن مَن بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن مَن دَنا فتدلّى فكان من ربّه قاب قوسينِ أو أدنى، أنا ابن مَن صلّى بملائكة السما، أنا ابن مَن أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمّد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن مَن ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلّا الله، أنا ابن مَن ضرب بين يدَي رسول الله بسيفينِ، وطعن برمحينِ، وهاجر الهجرتينِ، وبايع البيعتينِ، وصلّى القبلتينِ، وقاتل ببدرٍ وحُنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيّين، وقامع الملحدين، ويعسوب المسلمين، ونور المجاهدين، وزين العابدين، وتاج البكّائين، وأصبر الصابرين، وأفضل القائمينَ من آل ياسين ورسول ربّ العالمين، أنا ابن المؤيّد بجبرائيل، والمنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حُرم المسلمين، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين، والمجاهد أعداءه الناصبين، وأفخر مَن مشى من قريش أجمعين، وأول مَن أجاب واستجاب لله من المؤمنين، وأقدم السابقين، وقاصم المعتدين، ومبير المشركين، وسهم من مرامي الله على المنافقين، ولسان كلمة العابدين، ناصر دين الله، ووليّ أمر الله، وبستان حكمة الله، وعيبة علم الله، سمح سخي، بهلول زكي أبطحي، رضي مرضي، مقدام همام، صابر صوّام، مهذّب قوّام، شجاع قمقام، قاطع الأصلاب، ومفرّق الأحزاب، أربطهم جَناناً، وأطبقهم عناناً، وأجرأهم لساناً، وأمضاهم عزيمة، وأشدّهم شكيمة، أسد باسل، وغيث هاطل، يطحنهم في الحروب إذا أزدلفت الأسنّة وقربت الأعنّة طحن الرحى، ويذروهم ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز، وصاحب الإعجاز، وكبش العراق، الإمام بالنصّ والاستحقاق، مكيّ مدنيّ، أبطحيّ تهاميّ، خيفيّ عقبيّ، بدريّ أُحديّ، شجريّ مهاجريّ، من العرب سيّدها، ومن الوغى ليثها، وارث المشعرينِ، وأبو السبطينِ الحسن والحسين، مظهر العجائب، ومفرّق الكتائب، والشهاب الثاقب، والنور العاقب، أسد الله الغالب، مطلوب كلّ طالب، غالب كلّ غالب، ذاك جدّي علي بن أبي طالب. أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيّدة النساء، أنا ابن الطهر البتول، أنا ابن بضعة الرسول. قال: ولم يزل يقول: أنا أنا حتى ضجّ النّاس بالبكاء والنحيب»([1584]).
ملحق رقم (4)
طريق البادية بين الكوفة ودمشق
المصدر: الخريطة من إعداد الباحث[1585]
ملحق رقم (5)
طريق الفرات بين الكوفة ودمشق
المصدر: الخريطة من إعداد الباحث[1586]
ملحق رقم (6)
طريق دجلة بين الكوفة ودمشق
المصدر: الخريطة من إعداد الباحث[1587]
ملحق رقم (7)
الطريق الذي سلكته قافلة سبايا آل البيت^

 المصدر: الخريطة من إعداد الباحث[1588]
المصدر: الخريطة من إعداد الباحث[1588]
ملحق رقم (8)
مخطط دمشق القديمة[1589]
المصدر: لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص 432.
ملحق رقم (9)
مخطط دار الخضراء وقصر يزيد الملاصق للمسجد على يمين الداخل من باب جيرون[1590]
المصدر: لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص449.
ملحق رقم (10)
خارطة توضّح أسماء المواضع التي مرّت بها قافلة السبايا (في محافظة بابل حاليا)[1591]


 المصدر: الخريطة من إعداد الباحث
المصدر: الخريطة من إعداد الباحث


 ملحق رقم (11)
ملحق رقم (11)
خارطة توضّح أسماء المواضع التي مرّت بها
قافلة السبايا (في محافظة بغداد حاليا)[1592]





 المصدر: الخريطة من إعداد الباحث
المصدر: الخريطة من إعداد الباحث
 ملحق رقم (12)
ملحق رقم (12)
جدول يوضح اسماء المدن التي مرت بها السبايا والمسافات بينها داخل العراق
|
ت |
من |
الى |
خط مستقيم إزاحة ( GPS) |
طريق السيارة |
|
1 |
كربلاء |
النخيلة |
53 كم |
57 كم |
|
2 |
النخيلة |
الحنانة |
26كم |
32 كم |
|
3 |
الحنانة |
الكوفة |
7 كم |
8 كم |
|
4 |
الكوفة |
الحيرة |
18 كم |
30 كم |
|
5 |
الحيرة |
القادسيّة |
19 كم |
|
|
6 |
القادسيّة |
شوشي |
54 كم |
|
|
7 |
شوشي |
اليعقوبية |
|
|
|
8 |
اليعقوبية |
سوق أسد |
|
|
|
9 |
سوق أسد |
قصر ابن هبيرة |
|
|
|
10 |
قصر ابن هبيرة |
بزيقيا |
|
|
|
11 |
بزيقيا |
نهر كوثى |
|
|
|
12 |
نهر كوثى |
نهر الملك |
|
|
|
13 |
نهر الملك |
نهر صرصر |
|
|
|
14 |
نهر صرصر |
تل كوش |
|
|
|
15 |
تل كوش |
نهر الحسيني |
|
|
|
16 |
نهر الحسيني |
الحمارات |
|
|
|
ت |
من |
الى |
خط مستقيم إزاحة ( GPS) |
طريق السيارة |
|
17 |
الحمارات |
الفرحاتية |
|
|
|
18 |
الفرحاتية |
المحادر |
|
|
|
19 |
المحادر |
مهيجر |
|
|
|
20 |
مهيجر |
تكريت |
|
|
|
21 |
تكريت |
وادي نخلة |
|
|
|
22 |
وادي نخلة |
بارما |
|
|
|
23 |
بارما |
البلاليق |
|
|
|
24 |
البلاليق |
الكحيل |
|
|
|
25 |
الكحيل |
جهينة |
|
|
|
26 |
جهينة |
حمام العليل |
|
|
|
27 |
حمام العليل |
الموصل |
|
28 كم |
|
28 |
الموصل |
بلد |
|
|
|
29 |
بلد |
تلعفر |
|
|
|
30 |
تلعفر |
سنجار |
|
|
|
31 |
سنجار |
جبل سنجار |
|
|
|
32 |
الكوفة |
تكريت |
294 كم |
330 كم |
|
33 |
الكوفة |
حمام العليل |
472 كم |
526 كم |
|
34 |
الكوفة |
الموصل |
493 كم |
561 كم |
|
ت |
من |
الى |
خط مستقيم إزاحة ( GPS) |
طريق السيارة |
|
35 |
الكوفة |
تلعفر |
515 كم |
617 كم |
|
36 |
الكوفة |
سنجار |
531 كم |
671 كم |
|
37 |
الكوفة |
جبل سنجار |
545 كم |
704 كم |
|
38 |
الكوفة |
الحدود |
579 كم |
724 كم |
|
39 |
الكوفة |
نصيبين عبر مدينة القامشلي |
633 كم |
|
|
40 |
الموصل |
سنجار |
114كم |
123كم |
المصدر: محمّد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص268 ـ 269.
ملحق رقم (13)
جدول يوضّح أسماء المدن التي مرّت بها السبايا والمسافات بينها داخل الجمهورية اللبنانية
|
ت |
من |
الى |
خط مستقيم إزاحة ( GPS) |
طريق السيارة |
|
1 |
بداية الحدود |
اللبوة |
31 كم |
35 كم |
|
2 |
بداية الحدود |
الهرمل |
15 كم |
22 كم |
|
3 |
الهرمل |
اللبوة |
33 كم |
29 كم |
|
4 |
اللبوة |
بعلبك |
26 كم |
30 كم |
|
5 |
بعلبك |
معربون |
17 كم |
33 كم |
|
6 |
معربون |
الحدود مع سوريا |
1 كم |
لا يوجد |
|
المجموع |
113 كم |
149 كم |
||
المصدر: محمّد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص565.
ملحق رقم (14)
جدول يوضّح أسماء المدن التي مرت بها السبايا والمسافات التي بينها داخل الجمهورية العربية السورية
|
ت |
من |
الى |
خط مستقيم إزاحة ( GPS) |
طريق السيارة |
|
1 |
رأس العين |
الرقة |
136 كم |
200 كم |
|
2 |
الرقة |
قلعة دوسر |
49 كم |
58 كم |
|
3 |
قلعة دوسر |
بالس ـ مسكنة |
41 كم |
70 كم |
|
4 |
بالس ـ مسكنة |
حلب |
84 كم |
110 كم |
|
5 |
حلب |
قنسرين ـ العيس |
26 كم |
37 كم |
|
6 |
قنسرين ـ العيس |
معرة النعمان |
49 كم |
77 كم |
|
7 |
معرة النعمان |
كفر طاب |
23 كم |
28 كم |
|
8 |
كفر طاب |
شيزر |
44 كم |
34 كم |
|
9 |
شيزر |
حماة |
23 كم |
36 كم |
|
10 |
حماة |
الرستن |
24 كم |
28 كم |
|
11 |
الرستن |
حمص |
22 كم |
27 كم |
|
12 |
حمص |
القصير |
29 كم |
33 كم |
|
13 |
القصير |
الجوسية |
7 كم |
11 كم |
|
14 |
الجوسية |
الحدود |
4 كم |
7 كم |
|
المجموع |
561 كم |
756 كم |
||
|
المصدر: محمّد عبد الغني، من كربلاء إلى دمشق: ص661. |
||||
ملحق رقم (15)
جدول يوضّح أسماء المدن والمسافات بينها داخل العراق (من بغداد إلى الموصل)
|
من |
الى |
المسافة بالفرسخ |
المسافة (كم) |
|
|
بغداد |
البردان |
4 |
19 |
|
|
البردان |
عكبرا |
5 |
24 |
|
|
عكبرا |
باحمشا |
3 |
14 |
|
|
باحمشا |
القادسيّة |
7 |
33 |
|
|
القادسيّة |
سر من رأى |
3 |
14 |
|
|
سر من رأى |
الكرخ |
2 |
9 |
|
|
الكرخ |
جبلنا |
7 |
33 |
|
|
جبلنا |
السودقانية |
5 |
24 |
|
|
السودقانية |
بارِمّا |
5 |
24 |
|
|
بارِمّا |
السِنّ |
5 |
24 |
|
|
السِنّ |
الحديثة |
12 |
57 |
|
|
الحديثة |
بني طميان |
7 |
33 |
|
|
بني طميان |
الموصل |
7 |
33 |
|
|
المصدر: ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص93. |
|
||||
ملحق رقم (16)
جدول يوضّح أسماء المدن والمسافات بينها داخل العراق (من الموصل إلى نصيبين)
|
من |
الى |
المسافة بالفرسخ أو الميل |
المسافة (كم) |
|
الموصل |
بلد |
7 |
33 |
|
بلد |
باعيناتا |
6 |
28 |
|
باعيناتا |
برقعيد |
6 |
28 |
|
برقعيد |
أذرمة |
6 |
28 |
|
أذرمة |
تل فراشة |
5 |
27 |
|
تل فراشة |
نصيبين |
4 |
26 |
المصدر: ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص 95.
ملحق رقم (17)
جدول يوضّح أسماء المدن والمسافات بينها داخل العراق (من الرقة إلى دمشق)
|
من |
الى |
المسافة بالميل |
المسافة (كم) |
|
الرقة |
الرصافة |
24 |
38 |
|
الرصافة |
الزراعة |
40 |
64 |
|
الزرعة |
القسطل |
36 |
57 |
|
القسطل |
سليمة |
30 |
48 |
|
سليمة |
حمص |
24 |
38 |
|
حمص |
شمسين |
18 |
28 |
|
شمسين |
قارا |
22 |
35 |
|
قارا |
النبك |
10 |
16 |
|
النبك |
القطيفة |
20 |
32 |
|
القطيفة |
دمشق |
24 |
38 |
المصدر: ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص 98.
ملحق رقم (18)
جدول يوضّح أسماء المدن والمسافات بينها داخل العراق (من بغداد إلى القادسيّة)
|
من |
الى |
المسافة بالفرسخ أو الميل |
المسافة (كم) |
|
مدينة السلام |
جسر كُوثى |
سبعة فراسخ |
33 |
|
جسر كُوثى |
قصر ابن هبيرة |
خمسة فراسخ |
24 |
|
قصر ابن هبيرة |
سوق أسد |
سبعة فراسخ |
33 |
|
سوق أسد |
ساهي |
خمسة فراسخ |
24 |
|
ساهي |
الكوفة |
خمسة فراسخ |
24 |
|
الكوفة |
القادسيّة |
خمسة عشر ميلاً |
24 |
المصدر: ابن خرداذبة، المسالك والممالك، ص 185.
ملحق رقم (19)
جدول يوضّح أسماء المدن والمسافات بينها (من الكوفة إلى المدينة)
|
من |
الى |
المسافة بالميل |
المسافة (كم) |
|
الكوفة |
القادسيّة |
خمسة عشر ميلاً |
24 |
|
القادسيّة |
العُذيب |
ستة أميال |
9 |
|
العذيب |
المغيثة |
أربعة عشر ميلاً |
23 |
|
المغيثة |
القرعاء |
اثنان وثلاثون ميلاً |
51 |
|
القرعاء |
واقصة |
أربعة وعشرون ميلاً |
38 |
|
العقبة |
القاع |
أربعة وعشرون ميلاً |
38 |
|
القاع |
زُبالة |
أربعة وعشرون ميلاً |
38 |
|
زبالة |
الشقوق |
ثمانية عشر ميلاً |
28 |
|
الشقوق |
قبر العبادي |
تسعة وعشرون ميلاً |
46 |
|
قبر العبادي |
الثعلبية |
تسعة وعشرون ميلاً |
46 |
|
الثعلبية |
الخُزيمية |
ثلاثة وثلاثون ميلاً |
53 |
|
الخزيمية |
الأجفر |
أربعة وعشرون ميلاً |
38 |
|
الأجفر |
فيد |
ستة وثلاثون ميلاً |
57 |
|
فيد |
توز |
ثلاثة وثلاثون ميلاً |
53 |
|
توز |
سَميراء |
ستة عشر ميلاً |
25 |
|
سميراء |
الحاجر |
ثلاثة وعشرون ميلاً |
37 |
|
الحاجر |
النقرة |
سبعة وعشرون ميلاً |
43 |
|
النقرة |
مغيثة الماوان |
سبعة وعشرون ميلاً |
43 |
|
مغيثة |
الربذة |
أربعة وعشرون ميلاً |
38 |
|
الربذة |
معدن بني سليم |
تسعة عشر ميلاً |
30 |
|
معدن بني سليم |
العمق |
ستة وعشرون ميلاً |
41 |
|
العمق |
أفاعية |
اثنان وثلاثون ميلاً |
51 |
|
أفاعية |
المسلح |
أربعة وثلاثون ميلاً |
54 |
|
المسلح |
الغمرة |
ثمانية عشر ميلاً |
28 |
|
ومن الغمرة |
ذات عرقٍ |
ستة وعشرون ميلاً |
41 |
|
النقرة |
العُسَيلة |
ستة وأربعون ميلاً |
74 |
|
العسيلة |
بطن النخل |
ستة وثلاثون ميلاً |
57 |
|
بطن النخل |
الطَّرَف |
اثنان وعشرون ميلاً |
35 |
|
الطرف |
المدينة |
خمسة وثلاثون ميلاً |
56 |
المصدر: ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص184 ـ 185.
الملاحق
ملحق رقم (20)
جدول يوضّح أسماء المدن والمسافات بينها داخل العراق (من بغداد إلى الكوفة)
|
من |
الى |
المسافة (الميل) |
المسافة (كم) |
|
بغداد |
جسر النهر |
10 |
16 |
|
جسر النهر |
صرصر |
10 |
16 |
|
صرصر |
نهر الملك |
6 |
9 |
|
نهر الملك |
نهر كوثى |
4 |
6 |
|
نهر كوثى |
بزيقياء |
3 |
4 |
|
بزيقياء |
قصر بن هبيرة |
9 |
14 |
|
قصر بن هبيرة |
جسر سوران |
2 |
3 |
|
جسر سوران |
ذمار |
9 |
14 |
|
ذمار |
سوق أسد |
7 |
11 |
|
سوق أسد |
اليعقوبية |
10 |
16 |
|
اليعقوبية |
القناطر |
7 |
11 |
|
القناطر |
شاهي |
10 |
16 |
|
شاهي |
كوفة |
18 |
28 |
قائمة المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
* سبط بن الجوزي، شمس الدين أبو المظفر يوسف بن فرغلي (ت654هـ/ 1256م).
1. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان حوادث سنة (50 ـ 89هـ)، مخطوط مصوّر في مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة، النجف الأشرف، برقم (2/1/17).
2. أُسْدُ الغابة في معرفة الصحابة، (بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت).
3. الكامل في التاريخ، (بيروت، دار صادر، 1386هـ/1966م).
4. اللباب في تهذيب الأنساب، (تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار صادر، د.ت).
* ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمّد الجزري (ت606هـ/ 1209م).
5. النهاية في غريب الحديث والأثر، (تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمّد، ط4، قم، مؤسسة اسماعيليان، 1364ش).
* ابن البراج، عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (ت481هـ/1088م).
6. المهذب، (إشراف: جعفر السبحاني، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1406هـ/1985م).
* ابن البطريق، يحيى بن الحسن الأسدي (ت600هـ/1204م).
7. خصائص الوحي المبين، (تحقيق: مالك المحمودي، ط1، قم، مطبعة نكين، 1417هـ/1996م).
8. عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، (قم، مؤسسة النشر الإسلامي جماعة المدرسين، 1407هـ/1987م).
* ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد (ت597هـ/1200م).
9. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد، (ط، بيروت، دار الكتب العلمية، 1404هـ/1984م).
10. كشف المشكل من حديث الصحيحين، (تحقيق: علي حسين البواب، ط1، الرياض، دار الوطن، 1418هـ/1997م).
11. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، (تحقيق: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية،1412هـ/1992م).
12. الموضوعات، (تحقيق: عبد الرحمن محمّد عثمان، ط1، المدينة المنوّرة، المكتبة السلفية، 1386هـ/1966م).
* ابن السكّيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت244هـ/859م).
13. ترتيب إصلاح المنطق، (تحقيق: محمّد حسن بكائي، ط1، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1412هـ/1991م).
* ابن الصبّاغ المالكي، علي بن محمّد بن أحمد (ت855هـ/1451م).
14. الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة، (تحقيق: سامي الغريزي، ط1، د.م، دار الحديث للطباعة والنشر، 1422هـ/2001م).
* ابن العديم، عمر بن أحمد بن أبي جرادة (ت660هـ/1262م).
15. بغية الطلب في تاريخ حلب، (تحقيق: سهيل زكار، بيروت، مؤسسة البلاغ، 1408هـ/1988م).
* ابن العربي، أبو بكر بن العربي المالكي (ت543هـ/1148 م).
16. أحكام القرآن، (تحقيق: محمّد عبد القادر عطا، بيروت، دار الفكر العربي، د.ت).
* ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمّد بن العماد (ت1089هـ/1679م).
17. شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب، (بيروت، دار حياء التراث العربي، د.ت).
* ابن العمراني، محمّد بن علي بن محمّد (ت580هـ/1184م).
18. الأنباء في تاريخ الخلفاء، (تحقيق: قاسم السامرائي، ط1، القاهرة، دار الآفاق، 1421هـ/2001م).
* ابن الفقيه، أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن إسحاق الهمداني (ت365هـ/ 975م).
19. كتاب البلدان، (تحقيق: يوسف الهادي، ط1، بيروت، عالم الكتب، 1416هـ/1996م).
* ابن الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب الكلبي (ت204هـ/ 819م).
20. جمهرة أنساب العرب، (تحقيق: ناجي حسن، بيروت، عالم الكتب، د.ت).
21. نسب معد واليمن الكبير، (تحقيق: ناجي حسن، ط1، بغداد، مكتبة النهضة، 1408هـ/1987م).
* ابن المغازلي، أبو الحسن علي بن محمّد بن محمّد الواسطي الجُلّابي الشافعي (ت483هـ/1090م).
22. مناقبُ علي بن أبي طالب×، (ط1، د.م، مطبعة سبحان، 1426هـ/2005م).
* ابن النديم، أبو الفرج محمّد بن أبي يعقوب إسحاق (ت438هـ/1046م).
23. الفهرست، (تحقيق: رضا تجدد، مصر، د.ط، د.ت).
* ابن الوردي، زين الدين أبو حفص عمر بن مظفّر بن عمر بن محمّد بن الوردي المعري الكندي (ت749هـ/1343م).
24. تاريخ ابن الوردي، (ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417هـ/ 1996م).
25. خريدة العجائب وفريدة الغرائب، (تحقيق: أنور محمود زناتي، ط1، القاهرة، مكتبة الثقافة الإسلامية، 1428هـ/2008م).
* ابن إدريس، أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن إدريس العجلي الحلّي (ت598هـ/1201م).
26. أجوبة مسائل ورسائل في مختلف فنون المعرفة، (تحقيق: محمّد مهدي الموسوي الخرسان، ط1، النجف، العتبة العلوية المقدّسة، 1429هـ/ 2008م).
27. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، (تحقيق: لجنة من المحقّقين، ط2، د.م، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت).
* ابن إسحاق، محمّد بن إسحاق المطلبي (ت151هـ/768 م).
28. السير والمغازي، (تحقيق: محمّد حميد الله، د.م. معهد الدراسات والأبحاث للتعريف، د.ت).
* ابن أبي الحديد، عزّ الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد المدائني (ت656هـ/1258م).
29. شرح نهج البلاغة، (تحقيق: محمّد أبو الفضل ابراهيم، ط1، القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، 1378هـ/1959م).
* ابن أبي حاتم، أبو محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمّد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي (ت327هـ/939م).
30. الجرح والتعديل، (ط1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1371هـ/1952م).
* ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت287هـ/ 900م).
31. الآحاد والمثاني، (تحقيق: بإسم فيصل، ط1، الرياض، دار الراية، 1411هـ/1991م).
* ابن أعثم، أبو محمّد أحمد بن أعثم الكوفي (ت314هـ/926م).
32. الفتوح، (تحقيق: علي شيري، ط1، بيروت، دار الأضواء، 1411هـ/ 1990م).
* ابن أنس، مالك (ت179هـ/795م).
33. الموطأ، (تعليق: محمّد فؤاد عبد الباقي، بيروت، إحياء التراث العربي، 1406هـ/1985م).
* ابن بطوطة، محمّد بن عبد الله اللواتي (ت779هـ/1377م).
34. تحفة النظار في غرائب الأمصار (الرحلة)، (تحقيق: طلال حرب، بيروت، دار الكتب العلمية، 1407هـ/1987م).
* ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الله الظاهري الحنفي (ت874هـ/1469م).
35. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، (مصر، دار الكتب، د.ت).
* ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت728هـ/1327م).
36. رأس الحسين، (تحقيق: السيد الجميلي، ط1، بيروت، دار الكتاب العربي، 1406هـ/1985م).
* ابن جبر، زين الدين علي بن يوسف (تق7هـ/ق13م).
37. نهج الإيمان، (تحقيق: السيد أحمد الحسيني، ط1، قم، مطبعة الستاره، 1418هـ/1997م).
* ابن جبير، أبو الحسين محمّد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي الشاطبي البلنسي (ت614هـ/1217م).
38. تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار (الرحلة)، (بيروت، دار ومكتبة الهلال، د.ت).
* ابن جعفر، قدامة (ت337هـ/933م).
39. الخراج وصناعة الكتابة، (تحقيق: محمّد حسين الزبيدي، بغداد، دار الرشيد، 1400هـ/1980م).
* ابن حبان، محمّد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي (ت354هـ/ 965م).
40. الثقات، (مراقبة: محمّد عبد المعيد خان، ط1، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1393هـ/1973م).
41. مشاهير علماء الأمصار، أعلام فقهاء الأقطار، (تحقيق: مرزوق علي إبراهيم، ط1، المنصورة، دار الوفاء للنشر والتوزيع، 1411هـ/1991م).
* ابن حبيب البغدادي، محمّد بن حبيب بن أميّة بن عمرو الهاشمي (ت245هـ/ 860م).
42. المحبر، (د.م، مطبعة الدائرة، 1361هـ/1942م).
* ابن حجر العسقلاني، شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر (ت852هـ/ 1449م).
43. الإصابة في تمييز الصحابة، (تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ/1994م).
44. تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمّة الأربعة، (بيروت، دار الكتاب العربي، د.ت).
45. تقريب التهذيب، (تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط2، بيروت، دار الكتب العالمية، 1415هـ/1995م).
46. تهذيب التهذيب، (ط1، بيروت، دار الفكر، 1404هـ/1984م).
47. فتح الباري، (ط2، بيروت، دار المعرفة، د.ت).
48. لسان الميزان، (ط2، بيروت، مؤسسة الاعلمي، 1390هـ/1971م).
* ابن حجر الهيثمي، أحمد بن حجر المكّي (ت974هـ/1566م).
49. الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة، (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2، القاهرة، شركة الطباعة الفنية المتّحدة، 1385هـ/ 1965م).
* ابن حزم، أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت456هـ/1064م).
50. جمهرة أنساب العرب، (تحقيق: لجنة من العلماء، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1403هـ/1983م).
51. المحلّى (د.م، دار الفكر، د.ت).
* ابن حمدان، أبو عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي (ت334هـ/945م).
52. الهداية الكبرى، (ط4، بيروت، مؤسسة البلاغ للطباعة والنشر والتوزيع، 1411هـ/1991م).
* ابن حمدون، محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي (ت562هـ/1166م).
53. التذكرة الحمدونية، (تحقيق: إحسان عباس وبكر عباس، ط1، بيروت، دار صادر، 1417هـ/1996م).
* ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمّد (ت241هـ/855م).
54. مسند الإمام أحمد بن حنبل، (بيروت، دار صادر، د.ت).
* ابن حوقل، أبو القاسم محمّد بن علي النصيبي (ت367هـ/977م).
55. صورة الأرض، (ط1، قم، المكتبة الحيدرية، 1428هـ/2008م).
* ابن خرداذبة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت300هـ/912م).
56. المسالك والممالك، (بيروت، دار صادر، 1307هـ/1889م).
* ابن خزيمة، أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (ت311هـ/923م).
57. صحيح ابن خزيمة، (تحقيق: محمّد مصطفى الأعظمي، ط2، د.م، المكتب الإسلامي، 1412هـ/1992م).
* ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمّد (ت808هـ/1405م).
58. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر ومَن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت).
* ابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان (ت681هـ/1282م).
59. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، (تحقيق: إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة، د.ت).
* ابن داود الحلّي، الحسن بن علي بن داود (ت707هـ/1307م).
60. رجال ابن داود، (تحقيق: محمّد صادق آل بحر العلوم، النجف، المطبعة الحيدرية، 1392هـ/1972م).
* ابن رسته، أحمد بن عمر (كان حيّاً في عام 290هـ/903م).
61. الأعلاق النفيسة، (تحقيق: ديوح باديس، ليدن، مطبعة بريل، 1309هـ/1891م).
* ابن زمنين المالكي، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عيسى بن محمّد الالبيري (ت399هـ/1008 م).
62. تفسير القرآن العزيز، (تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة، ط1، القاهرة، الفاروق الحديثة، 2002هـ/1423م).
* ابن سعد، محمّد بن سعد بن منيع الزهري (ت230هـ/845م).
63. ترجمة الإمام الحسين× من كتاب الطبقات، (ط1، د.م، الهدف للإعلام والنشر، د.ت).
64. الطبقات الكبرى، (بيروت، دار صادر، د.ت).
65. غزوات الرسول’ وسراياه، (تقديم: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشر، 1401هـ/1981م).
* ابن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت224هـ/839م).
66. غريب الحديث، (تحقيق: محمّد عبد المعيد خان، ط1، بيروت، دار الكتاب العربي، 1384هـ/1964م).
* ابن سيّد النّاس، محمّد بن عبد الله بن يحيى (ت734هـ/1334م).
67. السيرة النبوية (عيون الأثر)، (بيروت، مؤسسة عزّ الدين، 1406هـ/ 1986م).
* ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي (ت458هـ /1066م).
68. المحكم والمحيط الأعظم، (تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ/2000م).
69. المخصّص، (تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، بيروت، دار إحياءالتراث، د.ت).
* ابن شداد، عزّ الدين أبو عبد الله محمّد بن علي بن إبراهيم (ت684هـ/ 1285م).
70. الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، (تحقيق: دومينيك سورويل، دمشق، د.ط، 1372هـ/1953م).
* ابن شهر آشوب، أبو جعفر محمّد بن علي (ت588هـ/1192م).
71. معالم العلماء، (د.ط، د.م، د.ت).
72. مناقب آل أبي طالب، (قم، مؤسسة انتشارات، د.ت).
* ابن طاووس، رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسنّي الحلّي (ت664هـ/1266م).
73. إقبال الأعمال، (تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، ط1، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1414هـ/1993م).
74. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، (ط1، قم، مطبعة الخيام، 1399هـ/1978م).
75. اللهوف في قتلى الطفوف، (ط1، قم، مطبعة مهر، 1417هـ/1996م).
76. اليقين، (تحقيق: الأنصاري، ط1، الجزائر، مؤسسة دار الكتاب الجزائري، 1413هـ/1992م).
* ابن طاووس، عبد الكريم (ت693هـ/1293م).
77. فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي×، (تحقيق: تحسين آل شبيب الموسوي، ط1، بيروت، مكتب الغدير للدراسات الإسلامية، 1419هـ/1998م).
* ابن طولون، شمس الدين محمّد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي الحنفي (ت953هـ/1546 م).
78. قيد الشريد من أخبار يزيد، (تحقيق: فاطمة مصطفى عامر، القاهرة، دار العلوم، د.ت).
* ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر (ت280هـ/893م).
79. بلاغات النساء، (قم، مكتبة بصيرتي، د.ت).
* ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمّد (ت463هـ/1071م).
80. الاستذكار، (تحقيق: سالم محمّد عطا ومحمّد علي معوض، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1420هـ/2000م).
81. الاستيعاب في أسماء الأصحاب، (تحقيق: علي محمّد البجاوي، ط1، بيروت، دار الجيل، 1412هـ/1992م).
82. التمهيد، (تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمّد عبد الكبير البكري، المغرب، وزارة هموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387هـ/1964م).
* ابن عبد الحقّ، صفي الدين عبد المؤمن البغدادي (ت739هـ/1338م).
83. مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، (تحقيق: علي محمّد البجاوي، بيروت، د.ط، 1373هـ/1954م).
* ابن عبد الوهاب، حسين (تق5هـ/ق11م).
84. عيون المعجزات، (تحقيق: محمّد كاظم الشيخ صادق الكتبي، النجف، المطبعة الحيدرية، 1369هـ/1949م).
* ابن عبد ربّه، أبو عمر أحمد بن محمّد الأندلسي (ت328هـ/939م).
85. العقد الفريد، (ط2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1416هـ/ 1996م).
* ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة بن عبد الله الشافعي (ت571هـ/1175م).
86. تاريخ مدينة دمشق، (تحقيق: علي شيري، بيروت، دار الفكر، د.ت).
* ابن عنبة، جمال الدين أحمد بن علي الحسيني (ت828هـ/1424م).
87. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، (النجف، المطبعة الحيدرية، 1380هـ/1961م).
* ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ/1004م).
88. معجم مقاييس اللغة، (تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، بيروت، مكتبة الإعلام الإسلامي، 1404هـ/1998م).
* ابن قتيبة، أبو محمّد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت276هـ/889م).
89. الإمامة والسياسة (المنسوب)، (تحقيق: طه محمّد الزيني، مصر، مؤسسة الحلبي وشركاه، د.ت).
90. الشعر والشعراء، (تحقيق: أحمد محمّد شاكر، القاهرة، دار الحديث، 1427هـ/2006م).
91. غريب الحديث، ( تحقيق: عبد الله الجبوري، ط1، قم، دار الكتب العلمية، 1408هـ/1987م).
92. المعارف (تحقيق: ثروت عكاشة، ط2، مصر، دار المعارف، 1388هـ /1969م).
* ابن قدامه، موفق الدين أبو محمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد (ت620هـ/ 1223م).
93. المغني، (بيروت، دار الكتاب العربي للنشر، د.ت).
* ابن قولويه، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي (ت368هـ/ 979م).
94. كامل الزيارات، (تحقيق: جواد القيومي، ط1، بيروت، مؤسسة الإسلامي، 1417هـ/1986م).
* ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774هـ/ 1373م).
95. البداية والنهاية في التاريخ، (تحقيق: علي شيري، ط1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ/1988م).
96. السيرة النبوية، (تحقيق: مصطفى عبد الواحد، بيروت، دار المعرفة، 1396هـ/1971م).
97. قصص الأنبياء، (تحقيق: مصطفى عبد الواحد، ط1، مصر، دار التأليف، 1388هـ/1968م).
* ابن ماجه، أبو عبد الله محمّد بن يزيد (ت275هـ/888م).
98. سنن ابن ماجه، (تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، د.م، دار الفكر للطباعة والنشر، د.ت).
* ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبة الله العجلي (ت475هـ/1082م).
99. الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكُنى والأنساب، (القاهرة، دار إحياء التراث، د.ت).
* ابن مردويه، أبو بكر أحمد بن موسى ابن مَردويه الأصفهاني (ت410هـ /1019م).
100. مناقب عليّ بن أبي طالب وما نزل من القرآن في عليّ، (تحقيق: عبد الرزاق محمّد حسين حرز الدين، ط2، قم، دار الحديث 1424هـ/2003م).
* ابن مسكويه، أبو علي أحمد بن محمّد بن يعقوب الرازي (ت421هـ/ 1030م).
101. تجارب الأمم وتعاقب الهمم، (تحقيق: أبو القاسم إمامي، ط1، طهران، دار سروش، 1421هـ/2001م).
* ابن معين، يحيى بن معين بن عون المري الغطفاني البغدادي (233هـ/847م).
102. تاريخ ابن معين، (تحقيق: عبد الله أحمد حسن، بيروت، دار القلم، د.ت).
* ابن منجويه، أبو بكر أحمد بن علي بن محمّد بن إبراهيم (ت428هـ/1037م).
103. رجال صحيح مسلم، (تحقيق: عبد الله الليثي، ط1، بيروت، دار المعرفة، 1407هـ/1987م).
* ابن منده، أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن منده (ت395هـ/1005م).
104. فتح الباب في الكُنى والألقاب، (تحقيق: أبو قتيبة نظر محمّد الفاريابي، ط1، الرياض، مكتبة الكوثر، 1417هـ/1996م).
105. معرفة الصحابة، (تحقيق: عامر حسن صبري، ط1، الإمارات، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 1426هـ/2005م).
* ابن منظور، جمال الدين أبو الفضل محمّد بن مكرم بن منظور (ت711هـ/ 1311م).
106. لسان العرب، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت).
* ابن ناصر الدين، محمّد بن عبد الله بن محمّد بن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي (842هـ/1439م).
107. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، (تحقيق: محمّد نعيم العرقسوسي، ط1، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413هـ/ 1993م).
* ابن نما الحلّي، نجم الدين جعفر بن محمّد بن جعفر بن هبة الله بن نما (ت645هـ/1247م).
108. ذوب النضار في شرح الثار، (تحقيق: فارس حسون كريم، ط1، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1416هـ/1996م).
109. مثير الأحزان، (النجف، المطبعة الحيدرية، 1369هـ/1950م).
* ابن هشام، أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي (ت218هـ/833م).
110. السيرة النبوية، (تحقيق: محمّد محيي الدين عبد الحميد، القاهرة، مطبعة المدني، 1383هـ/1963م).
* الإدريسي، محمّد بن محمّد بن عبد الله بن إدريس الحسني الطالبي (ت56هـ /1164م).
111. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، (ط1، بيروت، عالم الكتب، 1409هـ/1988م).
* الإربلي، أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت693هـ/1293م).
112. كشف الغمة في معرفة الأئمّة، (ط2، بيروت، دار الأضواء، 1405هـ/ 1985م).
* الأزهري، أبو منصور محمّد بن أحمد بن
الأزهري الهروي (ت370هـ/
980م).
113. تهذيب اللغة، (تحقيق: محمّد عوض مرعب، ط1، بيروت، دار إحياء التراث، 1422هـ/2001م).
* الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت340هـ/1038م).
114. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، (بيروت، دار الكتاب العربي، د. ت).
* الأصبهاني، عبد الله بن حبان (ت369هـ/980 م).
115. طبقات المحدثين بأصبهان، (تحقيق: عبد الغفور عبد الحقّ حسين البلوشي، ط2، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1412هـ/1992م).
* الأصطخري، أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الفارسي (ت346هـ/975م).
116. مسالك الممالك، (بيروت، دار صادر، 1424هـ/2004م).
* الأنباري، أبو بكر محمّد بن القاسم بن محمّد بن بشّار (ت328هـ/940م).
117. الزاهر في معاني كلمات النّاس، (تعليق: يحيى مَراد، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1424هـ/2004م).
* الباجي المالكي، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب (ت474هـ/1081م).
118. التعديل والتجريح، (تحقيق: أحمد البزاز، مراكش، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، د.ت).
* الباعوني، شمس الدين أبو البركات محمّد بن أحمد (ت871هـ/1466م).
119. جواهر المطالب في مناقب علي بن أبي طالب، (تحقيق: محمّد باقر المحمودي، قم، مطبعة دانش، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، 1415هـ/ 1994م).
* البحراني، كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم (ت679هـ/1280م).
120. شرح نهج البلاغة، (تحقيق: عدّة من الأفاضل، ط1، إيران، چاپخانه دفتر تبليغات إسلامي، د.ت).
* البخاري، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي (ت256هـ/ 870م).
121. التاريخ الصغير، (تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط1، بيروت، دار المعرفة، 1406هـ/1985م).
122. التاريخ الكبير، (تركيا، المكتبة الإسلامية، د.ت).
123. صحيح البخاري، (بيروت، دار الفكر العربي، 1401هـ/1981م).
124. الضعفاء، (تحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط1، حلب، دار الوعي، 1396هـ/1976م).
* البخاري، أبو نصر أحمد بن محمّد بن الحسين بن الحسن الكلابذي (ت398هـ/1007م).
125. الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، (تحقيق: عبدالله الليثي، ط1، بيروت، دار المعرفة، 1407هـ/1986م).
* البرقي، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد (ت274هـ/887 م).
126. الرجال، (طهران، المطبعة چاخانه دانشگاه، د.ت).
127. المحاسن، (تحقيق: السيد جلال الدين الحسيني، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1370هـ/1951م).
* البري، محمّد بن أبي بكر الأنصاري (تق7هـ/ق13م).
128. الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، (تحقيق: محمّد التونجي، ط1، دمشق، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1402هـ).
* البغوي، أبو محمّد الحسين بن مسعود بن محمّد الفراء، (ت510هـ/1116م).
129. معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير لغوي)، (تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، بيروت، دار المعرفة، د.ت).
* البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي، (ت487هـ/1094م).
130. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، (تحقيق: مصطفى السقا، ط3، بيروت، عالم الكتب، 1403هـ/1983م).
* البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر (ت279هـ/892م).
131. أنساب الأشراف، (تحقيق: محمّد باقر المحمودي، ط1، بيروت، دار التعارف، 1397هـ/1977م).
132. فتوح البلدان، (القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، د.ت).
* البيروني، أبو الريحان محمّد بن أحمد (ت440هـ/1408م).
133. الآثار الباقية عن القرون الخالية، (بغداد، د.ط، د.ت).
* البيهقي، إبراهيم بن محمّد (ت320هـ/932 م).
134. المحاسن والمساوئ، (د.م، د.ط، د.ت).
* البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت458هـ/1066م).
135. دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، (تحقيق: عبد المعطي قلعجي، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1405هـ/1985م).
136. السنن الكبرى، (بيروت، دار المعرفة، د.ت).
137. شعب الإيمان، (تحقيق: أبو هاجر محمّد السعيد، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1410هـ/1990م).
138. معرفة السنن والآثار، (تحقيق: سيّد كسروي حسن، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت).
* البيهقي، ظهير الدين أبو الحسن علي بن أبي القاسم زيد، المعروف بإبن فندق (ت565هـ/1169م).
139. لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، (تحقيق: مهدي الرجائي، د.م، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، 1427هـ/2007م).
140. معارج نهج البلاغة، (تحقيق: محمّد تقي دانش پژوه، ط1، قم، مطبعة بهمن، 1409هـ/1989م).
* التبريزي، ولي الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت741هـ/1340م).
141. الإكمال في أسماء الرجال، (تحقيق: أبو أسد الله بن الحافظ محمّد عبد الله الأنصاري، د.م، مؤسسة أهل البيت، د.ت).
* الترمذي، أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة (ت279هـ/892م).
142. سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، (تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2، بيروت، دار الفكر العربي، 1403هـ/1983م).
* التفتازي، سعد الدين (ت792هـ/1389م).
143. مختصر المعاني، (ط1، قم، دار الفكر، 1411ه /1990م).
* الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمّد بن مخلوف المالكي (ت875هـ/ 1470م).
144. الجواهر الحسان في تفسير القرآن، (تحقيق عبد الفتاح أبو سنة وآخرون، ط1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1418هـ/1998م).
* الثعالبي، عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل أبو منصور (ت429هـ/1037م).
145. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، (القاهرة، دار المعارف، د.ت).
146. فقه اللغة وسرّ اللغة، (تحقيق: فائز محمّد، مراجعة: إميل يعقوب، ط2، بيروت، دار الكتاب العربي، 1416هـ/1996م).
* الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري (ت427هـ/1035م).
147. الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبي)، (تحقيق: أبو محمّد بن عاشور ونظير الساعدي، ط1، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1422هـ/2002م).
* الثقفي، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفي (ت283هـ/896م).
148. الغارات، (تحقيق: جلال الدين الحسيني، بهمن، د.ت).
* الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (ت255هـ/869م).
149. البرصان والعرجان والعميان والحولان، (تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، ط1، بيروت، دار الجيل، 1410هـ/1990م).
150. رسائل الجاحظ (رسالة في النابتة)، (تحقيق: محمّد طه الحاجري، بيروت، دار النهضة، 1403هـ/1983م).
* الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت393هـ/1003م).
151. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، (تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ط4، بيروت، دار العلم للملايين، 1407هـ/1987م).
* الجوهري، أبو بكر أحمد بن عبد العزيز البصري (ت323هـ/935م).
152. السقيفة وفدك، (تقديم وجمع وتحقيق: الدكتور الشيخ محمّد هادي الأميني، ط2، بيروت، شركة الكتبي للطباعة والنشر، 1413هـ/ 1993م).
* الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن البيع (ت405هـ/ 1014م).
153. المستدرك على الصحيحين، (تحقيق: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، بيروت، دار المعرفة، د.ت).
* الحربي، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق (ت285هـ/898م).
154. غريب الحديث، (تحقيق: سليمان بن إبراهيم بن محمّد العاير، ط1، جدّة، دار المدينة، 1405هـ/1984م).
* الحسكاني، عبيد الله بن أحمد (تق5هـ/ق11م).
155. شواهد التنزيل لقواعد التفصيل، (تحقيق: محمّد باقر المحمودي، ط1، د.م، مؤسسة الطبع والنشر، 1411هـ/1990م).
* الحسن بن محمّد، أبو محمّد الحسن بن محمّد الديلمي (تق8).
156. إرشاد القلوب، (ط2، قم، أمير، انتشارات الشريف الرضي، 1415هـ/1994م).
* الحلّي، أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي (ت726هـ/ 1326م).
157. خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، (تحقيق: جواد القيومي، ط1، د.م، مؤسسة نشر الفقاهة، 1417هـ/1997م).
158. كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين، (تحقيق: حسين الدرگاهي، أبو محمّد حسن حسين آبادي، ط1، طهران، د.ط، 1411هـ/1991م).
159. منتهى المطلب في تحقيق المذهب، (تحقيق: علي أكبر الغفاري، ط1، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، 1421هـ/2000م).
160. نهج الحقّ وكشف الصدق، (تحقيق: عين الله الحسني الأرموي، قم، مطبعة ستارة، 1412هـ/1992م).
* الحلّي، عزّ الدين أبو محمّد الحسن بن سليمان بن محمّد (ت أوائل ق 9هـ/ق15م).
161. مختصر بصائر الدرجات، (ط1، النجف الأشرف، المطبعة الحيدرية، 1370هـ/1950م).
* الحلّي، يحيى بن سعيد (ت689هـ/1290م).
162. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، (تحقيق: أحمد الحسيني، نور الدين الواعظي، النجف، 1386هـ/1966م).
* الحميري، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت900هـ/1495م).
163. الروض المعطار في خبر الأقطار، (تحقيق: إحسان عباس، ط2، بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة، 1400هـ/1980م).
* الحميري، نشوان سعيد اليمني (573هـ/1177م).
164. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، (تحقيق: الدكتور حسين بن عبد الله العمري والدكتور يوسف محمّد عبد الله، ط1، بيروت، دار الفكر المعاصر، 1420هـ/1999م).
* الحنفي، شمس الدين محمّد بن يوسف الزرندي (ت750هـ/1349م).
165. معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول’، (تحقيق: ماجد بن أحمد العطية، د.م، د.ط، د.ت).
* الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي (ت463هـ/1071م).
166. تاريخ بغداد (مدينة السلام)، (تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417هـ/1997م).
* الخطيب، أحمد بن حسن (ت809هـ/1407م ).
167. الوفيات، (تحقيق: عادل نويهض، ط1، بيروت، دار الإقامة الجديدة، 1398هـ/1978م).
* الخوارزمي، أبو المؤيّد الموفق بن أحمد المكّي (ت568هـ/1172م).
168. مقتل الحسين، (تحقيق: محمّد السماوي، ط5، كربلاء، أنوار الهدى، 1431هـ/2010م).
* الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر (ت385هـ/995 م).
169. المؤتلف والمختلف، (تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ط، د.م، دار الغرب الإسلامية، 1407هـ/1986م).
* الدارمي، أبو محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي السمرقندي (ت255هـ/869م).
170. سنن الدارمي، (تحقيق: محمّد أحمد دهمان، دمشق، مطبعة الاعتدال، 1349هـ/1930م).
* الدميري، كمال الدين محمّد بن موسى بن عيسى (ت808هـ/1405م).
171. حياة الحيوان الكبرى، (ط2، بيروت، دار الكتب العالمية، 1424هـ/ 2004م).
* الدولابي، أبو بشر محمّد بن أحمد بن حماد الأنصاري الرازي (ت310هـ/ 922م).
172. الذرية الطاهرة النبوية، (تحقيق: سعد المبارك الحسن، ط1، الكويت، الدار السلفية، 1407هـ/1986م).
* الديار بكري، حسين بن محمّد بن الحسن (ت982هـ/1574م).
173. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، (ط1، د.م، مطبعة عثمان عبد الرزاق، 1302هـ/1885م).
* الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داوود (ت282هـ/895م).
174. الأخبار الطوال، (تحقيق: عبد المنعم عامر، ط1، القاهرة، دار إحياء التراث العربي، 1379هـ/1960م).
* الذهبي، شمس الدين محمّد بن أحمد بن عثمان الدمشقي الشافعي (ت748هـ/1347م).
175. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، (تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، ط1، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407هـ/1987م).
176. تذكرة الحفاظ، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت).
177. سير أعلام النبلاء، (تحقيق: حسين الأسد وشعيب الأرنؤوط، ط9، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1413هـ/1993م).
178. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، (تحقيق: علي محمّد البجاوي، ط1، بيروت، دار المعرفة، 1382هـ/1963م).
* الرازي، محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (ت721هـ/1321م).
179. مختار الصحاح، (تحقيق: أحمد شمس الدين، ط1، بيروت، دار إحياء الكتب العلمية، 1415هـ/1994م).
* الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمّد (ت425هـ/1033م).
180. المفردات في غريب الحديث، (ط2، د.م، دفتر نشر الكتاب، 1404هـ/ 1984م).
* الراوندي، قطب الدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله (ت573هـ/1167م).
181. الخرائج والجرائح، (تحقيق: محمّد باقر الموحد الأبطحي، ط1، قم، المطبعة العلمية، 1409هـ/1988م).
182. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، (تحقيق: عبد اللطيف الكوكهمري، قم، مطبعة الخيام، 1406هـ/1986م).
* الزبير بن بكار، أبو عبد الله بن أبي بكر بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ( 256هـ/869 م).
183. الأخبار الموفقيات، (تحقيق: سامي مكّي العاني، ط1، بيروت، عالم الكتب، 1416هـ/1996م).
* الزبيري، مصعب بن عبد الله (ت236هـ/850م).
184. نسب قريش، (تحقيق: ليفي بُرفنسال، ط3، القاهرة، دار المعارف، 1119هـ/1707م).
* الزرندي، جمال الدين محمّد بن يوسف بن الحسن بن محمّد (ت750هـ/ 1349م).
185. نظم درر السمطين، (ط1، د.م، مكتبة الإمام أمير المؤمنين، 1377هـ/1958م).
* الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمّد (ت538هـ/ 1143م).
186. أساس البلاغة، (القاهرة، دار ومطابع الشعب، 1380هـ/1960م).
187. الجبال والأمكنة والمياه، (تحقيق: أحمد عبد التوّاب عوض، القاهرة، دار الفضيلة، 1419هـ/1999م).
188. الفائق في غريب الحديث، (تحقيق: إبراهيم شمس الدين، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1417هـ/1996م).
189. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، (ط3، بيروت، 1407هـ/1986م).
* الزيلعي، عبد الله بن يوسف بن محمّد بن أيوب بن موسى الحنفي (ت762هـ/1360م).
190. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، (تحقيق: أيمن صالح شعبان، ط1، القاهرة، مطابع الوفاء، 1415هـ/1995م).
* السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي (ت275هـ/888م).
191. السنن، (تحقيق: محمّد الصباغ، بيروت، الدار العربية، د.ت).
* السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد (ت902هـ/1496م).
192. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، (ط1، بيروت، نشر الكتب العلمية، 1414هـ/1993م).
* السرخسي، مجد بن الحسن الشيباني (ت483هـ/1090م).
193. أصول السرخسي، (تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، ط1، بيروت، دار الكتب العلمة، 1414هـ/1993م).
194. شرح السير الكبير، (تحقيق: صلاح الدين المنجد، مصر، مطبعة مصر، 1380هـ/1960م).
195. المبسوط، (بيروت، دار المعرفة، 1406هـ/1986م).
* السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمّد بن منصور التميمي (ت562هـ/ 1166م).
196. الأنساب، (تحقيق: عبد الله عمر البارودي، ط1، بيروت، دار الجنان، 1408هـ/1987م).
* السمعاني، منصور بن محمّد بن عبد الجبّار (ت489هـ/1096م).
197. تفسير السمعاني، (تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، ط1، الرياض، دار الوطن، 1418هـ/1997م).
* السمهودي، نور الدين علي بن أحمد (ت911هـ/1505م).
198. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، (تحقيق: خالد عبد الغني، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ/1998م).
* السيرافي، أبو زيد حسن بن يزيد (ت330هـ/942م).
199. رحلة السيرافي، (د.م، نشر المجمع الثقافي، 1419هـ/1999م).
* السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ/ 1505م).
200. إسعاف المبطأ برجال الموطأ، (تحقيق: موفق فوزي جبر، ط1، بيروت، دار الهجرة للطباعة والنشر، 1410هـ/1989م).
201. تاريخ الخلفاء، (تحقيق: لجنة من الأدباء، بيروت، مطابع معتوق أخوان، د.ت).
202. تفسير الجلالين، (تقديم: مروان سوار، بيروت، دار المعرفة، د.ت).
203. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، (بيروت، دار المعرفة، د.ت).
204. كفاية الطالب، (الهند، مطبعة حيدر آباد الدكن، 1320هـ/1902م).
* الشابشتي، أبو الحسن علي بن محمّد (ت388هـ/998م).
205. الديارات (تحقيق: كوركيس عوّاد، ط3، بيروت، دار الرائد العربي، 1406هـ/1986م).
* الشافعي، أبو سالم كمال الدين محمّد بن طلحة (ت652هـ/1254م).
206. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول’، (تحقيق: ماجد أحمد العطية، بيروت، د.ط، 1420هـ/1999م).
* الشافعي، أبو عبد الله محمّد بن إدريس (ت204هـ/819م).
207. الأمّ، (ط2، د.م، دار الفكر، 1403هـ/1983م).
208. المسند، (بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت).
* الشجري، أبو السعادات هبة الله علي بن محمّد بن حمزة الحسيني العلوي (ت542هـ/1147م).
209. الأمالي الخميسية، (بيروت، عالم الكتب، د.ت).
* الشمشاطي، أبو الحسن علي بن محمّد بن المطهر العدوي (ت377هـ/ 987م).
210. الأنوار ومحاسن الأشعار، (د.م، د.ط، د.ت).
* الشهرستاني، محمّد بن عبد الكريم بن أبي بكر (ت548هـ/1153م).
211. الملل والنحل، (تحقيق: محمّد سيّد كيلاني، بيروت، دار المعرفة، 1404هـ/1984م).
* الشهيد الأول، محمّد بن مكّي العاملي (ت786هـ/1384م).
212. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، (تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط1، قم، مطبعة ستاره، 1419هـ/1999م).
213. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، (تحقيق: محمّد كلانتر، ط2، قم، مطبعة أمير، 1398هـ/1978م).
214. المزار، (تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي، ط1، قم، مطبعة أمير)، 1410هـ/1989م).
* الصالحي الشامي، محمّد بن يوسف (ت942هـ/1535م).
215. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، (تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمّد معوض، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414هـ/1993م).
* الصدوق، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي (ت381هـ/991م).
216. الأمالي، (تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، ط1، طهران، مؤسسة البعثة، 1417هـ/1997م).
217. الخصال، (تحقيق: علي أكبر الغفاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405هـ/1363م).
218. كمال الدين وإتمام النعمة، (تحقيق: علي أكبر الغفاري، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1405هـ/1363م).
* الصفار، أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ (ت290هـ/903 م).
219. بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمّد×، (تحقيق: كوچه باغي، طهران، منشورات الأعلمي، د.ت).
* الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله (ت764هـ/1363م).
220. الوافي بالوفيات، (تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420هـ/2000م).
* الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي (ت360هـ/971م).
221. الأحاديث الطوال، (تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1412هـ/1992م).
222. الأوائل، (تحقيق: محمّد شكور، ط1، بيروت، د. ط، 1408هـ/ 1987م).
223. المعجم الأوسط، (تحقيق: قسم التحقيق بدار الحرمين، المدينة المنوّرة، دار الحرمين، 1415هـ/1995م).
224. المعجم الصغير، (بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت).
225. المعجم الكبير، (تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، ط2، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1422هـ/2002م).
226. مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، (تحقيق: محمّد شجاع ضيف الله، الكويت، دار الأوراد، 1412هـ/1992م).
* الطبرسي، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (من أعلام ق6).
227. الاحتجاج، (تحقيق: محمّد باقر الخرسان، النجف، دار النعمان، 1386هـ/1966م).
228. تاج المواليد، (قم، مطبعة الصدر، 1406هـ/1986م).
* الطبرسي، أمين الإسلام أبو علي الفضل بن الحسن (ت548هـ/1135م)
229. إعلام الورى بأعلام الهدى، (تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط1، قم، د.ط، 1417هـ/1996م).
230. مجمع البيان في تفسير القرآن، (تحقيق: لجنة من العلماء، ط1، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1415هـ/1995م).
* الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير (ت310هـ/923م).
231. تاريخ الأمم والملوك، (بيروت، مؤسسة الأعلمي، د.ت).
232. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، (تحقيق: الشيخ خليل الميس وجميل صدفي العطار، بيروت، دار الفكر، 1415هـ/1995م).
233. المنتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين، (بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1358هـ/1939م).
* الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم (من أعلام ق5هـ/ق11م).
234. دلائل الإمامة، (ط1، قم، مؤسسة البعثة، 1413هـ/1993م).
235. المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، (تحقيق: أحمد المحمودي، قم، مؤسسة الواصف، 1415هـ/1994م).
236. نوادر المعجزات في مناقب الأئمّة الهداة، (تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي، ط1، قم، مؤسسة الإمام المهدي، 1410هـ/1990م).
* الطبري، عماد الدين الحسن بن علي بن محمّد (ت700هـ/1300م).
237. كامل البهائي، (ط1، د.م، المكتبة الحيدرية، 1384هـ/1964م).
* الطبري، عماد الدين أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم (ت553هـ/1108م).
238. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، (تحقيق: جواد القيومي، ط2، قم، د.ط، 1423هـ/2002م).
* الطوسي، ابن حمزة (ت560هـ/1164م).
239. الثاقب في المناقب، (تحقيق: نبيل رضا علوان، ط2، قم، الصدر، مؤسسة أنصاريان للطباعة، 1412هـ/1992م)،
* الطوسي، أبو جعفر محمّد بن الحسن (460هـ/1067م).
240. الأمالي، (تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية، ط1، قم، دار الثقافة، 1414هـ/1993م).
241. تهذيب الأحكام، (تحقيق: السيد حسن الموسوي الخرسان، ط3، طهران، مطبعة خورشيد، د.ت).
242. الخلاف، (تحقيق: جماعة من المحقّقين، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1407هـ/1986م).
243. رجال الطوسي، (تحقيق: جواد القيومي، ط1، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415هـ/1995م).
244. الفهرست، (تحقيق: جواد القيومي، ط1، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ/1997م).
245. مصباح المتهجّد، (ط1، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، 1411هـ/ 1991م).
* العاملي المشغري، يوسف بن حاتم الشامي (ت664هـ/1266م).
246. الدر النظيم، (قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت).
* العبيدلي، أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر الحجّة بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام السجّاد (ت277هـ/890م).
247. أخبار الزينبيّات، (تحقيق: محمّد الجواد الحسيني المرعشي النجفي، إيران، د.ط، د.ت).
* العجلي، أحمد بن عبد الله (ت261هـ/875).
248. معرفة الثقات، (ط1، المدينة المنوّرة، مكتبة الدار، 1405هـ/1985م).
* العمري، شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي (ت749هـ/1348م).
249. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، (ط1، أبو ظبي، المجمع الثقافي، 1423هـ/2002م).
* العمري، نجم الدين أبو الحسن على بن محمّد بن على بن محمّد العلوى (709هـ/1309م).
250. المجدي في أنساب الطالبيين، (تحقيق: أحمد المهدوى الدامغاني، ط1، قم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامّة، د.ت).
* العيني، أبو محمّد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفي (ت855هـ/1451م).
251. عمدة القاري، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت).
* الفتّال النيسابوري، أبو جعفر محمّد بن الحسن (ت508هـ/1114م ).
252. روضة الواعظين، (تحقيق: السيد محمّد مهدي السيد حسن الخرسان، قم، منشورات الشريف الرضي، د.ت).
* الفراهيدي، أبو عبد الرحمن أحمد (ت175هـ/791م).
253. العين، (تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، ط2، قم، مؤسسة دار الهجرة، 1409هـ/1989م).
* الفرزدق، أبو فراس همام بن غالب التميمي البصري (ت114هـ/732م).
254. الديوان، (تحقيق: علي فاعول، ط1، بيروت، د.ط، 1408هـ/1987م).
* الفيروزآبادي، مجد الدين محمّد بن يعقوب (ت817هـ/1414م).
255. القاموس المحيط والقاموس الوسيط في اللغة، (بيروت، دار العلم للملايين، د.ت).
* الفيومي، أحمد بن محمّد المقري (ت770هـ/1368م).
256. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، (بيروت، دار الفكر العربي، د.ت).
* القرشي، عماد الدين بن إدريس (ت872هـ/1467م).
257. عيون الأخبار وفنون الآثار، (تحقيق: غالب مصطفى، بيروت، دار التراث الفاطمي، 1392هـ/1973م).
* القرشي، كمال الدين محمّد بن طلحة بن محمّد (ت652هـ/1252م).
258. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، (تحقيق: ماجد بن محمّد العطية، النجف، دار الكتب التجارية، د.ت).
* القرطبي، شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاري الخزرجي (ت671هـ/1270م).
259. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، (تحقيق: الصادق بن محمّد بن ابراهيم، ط1، د.م، دار المنهاج، 1425هـ/2004م).
260. الجامع لأحكام القرآن، (تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1405هـ/1985م).
* القزويني، زكريا بن محمّد بن محمود (ت682هـ/1283م).
261. آثار البلاد وأخبار العباد، (بيروت، دار صادر، د.ت).
262. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، (ط3، مصر، شركة ومطبعة مصطفى البابي، 1376هـ/1956م).
* القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت646هـ/1248م).
263. إنباه الرواة على أنباه النحاة، (تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم، ط1، بيروت، دار الفكر العربي، 1406هـ/1982م).
* القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله (ت821هـ/ 1418م).
264. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، (تحقيق: محمّد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت).
265. مآثر الأنافة في معالم الخلافة، (تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، الكويت، سلسلة التراث العربي، 1964م).
266. نهاية الإرب في معرفة أنساب العرب، (بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت).
* القمّي، أبو الحسن علي بن إبراهيم (ت329هـ/941م).
267. تفسير القمّي، (تحقيق: طيب الموسوي الجزائري، ط3، قم، مؤسسة دار الكتاب، 1404هـ/1984م).
* القمّي، محمّد بن حسن (ت ق 7هـ/ق11م).
268. العقد النضيد والدرّ الفريد في فضائل أميرالمؤمنين وأهل بيت النبيّ^ (تحقيق: علي أوسط الناطقي، لطيف فرادي، ط1، قم، دار الحديث، 1423هـ/2002م).
* القيرواني، إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري (453هـ/1062م).
269. زهر الآداب وثمر الألباب، (بيروت، دارالجيل، د.ت).
* القيسي، أبو علي الحسن بن عبدالله (ت ق 6 م).
270. إيضاح شواهد الايضاح، (تحقيق: د. محمّد بن حمود الدعجاني، ط1، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1408هـ/1987م).
* الكتبي، محمّد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن (ت764هـ/1363م).
271. فوات الوفيات، (تحقيق: علي محمّد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1421هـ/2000م).
* الكشي، أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز (ت340هـ/951م).
272. رجال الكشي، (تعليق أحمد الحسيني، كربلاء، مؤسسة الأعلمي، د.ت).
* الكفعمي، تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن محمّد بن صالح (ت405هـ/1499م).
273. جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية (مصباح الكفعمي)، (بيروت، مؤسسة النعمان، 1412هـ/1992م).
* الكلاعي، أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الحميري الكلاعي الأندلسي (ت634هـ/1237م).
274. الاكتفاء بما تضمّنته من مغازي رسول الله| والثلاثة الخلفاء، (تحقيق: محمّد عبد القادر عطا، ط1، بيروت، دار الكتب العليمة، 1420هـ/ 2000م).
* الكليني، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي (ت329هـ/940م).
275. الكافي، (تحقيق: علي أكبر الغفاري، ط5، طهران، دار الكتب الإسلامية، د.ت).
* الكندي، أبو عمر محمّد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق (ت256هـ/870 م).
276. الولاة وكتاب القضاة (تصحيح: رفن كَست، بيروت، مطبعة الآباء اليسوعيين، 1325هـ/1908م).
* الكوفي، محمّد بن سليمان القاضي (حي 300هـ).
277. مناقب الإمام أميرالمؤمنين×، (تحقيق: محمّد باقر المحمودي، قم، مطبعة النهضة، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، 1412هـ/1992م).
* المالكي، أبو محمّد بن أبي طالب (ت436هـ/1044م).
278. الهداية إلى بلوغ النهاية، (تحقيق: مجموعة من الباحثين، ط1، الشارقة، جامعة الشارقة، د.ت).
* المجلسي، محمّد باقر بن محمّد تقي (ت1111هـ/1699م).
279. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، (ط2، بيروت، مؤسسة الوفاء، 1403هـ/1983م).
280. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول’، (قدّم له: مرتضى العسكري، إخراج ومقابلة وتصحيح: السيد هاشم الرّسولي، ط2، مطبعة مروي، نشر دار الكتب الإسلامية، 1404هـ/1983م).
* المحسن بن كرامة (ت454هـ/1062م).
281. تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين، (تحقيق: تحسين آل شبيب الموسوي، د.م، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، 1420هـ/2000م).
* المحقّق الحلّي، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن (ت676هـ/1277 م).
282. المعتبر (تحقيق: ناصر مكارم شيرازي، قم، مدرسة الإمام أمير المؤمنين×، د. ت).
* المحلي، حميد بن أحمد بن محمّد اليماني (ت652هـ/1254م).
283. الحدائق الوردية في مناقب أئمّة الزيدية، (تحقيق: المرتضى بن زيد المحطوري الحسني، ط1، صنعاء، مكتبة بدر، 1422هـ/2002م).
* المرتضى، علي بن حسين بن موسى (ت 436 هـ/1044م).
284. رسائل الشريف المرتضى، (تحقيق: أحمد الحسيني، إعداد: مهدي الرجائي، قم، مطبعة سيّد الشهداء، دار القرآن الكريم، 1405هـ/1984م).
* المزي، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (ت742هـ/1341م).
285. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، (تحقيق: بشار معروف، ط1، بيروت، دار الرسالة، 1422هـ/2002م).
* المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت346هـ/957م).
286. إثبات الوصيّة، (بيروت، دار الأضواء، 1408هـ/1988م).
287. التنبيه والإشراف، (تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي، القاهرة، دار الصاوي، د.ت).
288. مروج الذهب ومعادن الجوهر، (تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، ط4، مصر، مطبعة السعادة، 1384هـ/1964م).
* المشهدي، محمّد (ت ق 6هـ/ق12م).
289. المزار، (تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني، ط1، قم، نشر القيوم، 1419هـ/1998م).
* المطهّر الحلّي، رضي الدين علي بن يوسف (من أعلام ق8هـ/ق14م).
290. العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة، (تحقيق: مهدي الرجائي، ط1، قم، مكتبة المرعشي النجفي، 1408هـ/1988م).
* المفيد، أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي (ت413هـ/ 1022م).
291. الإختصاص، (تحقيق: علي أكبر الغفاري، قم، د.ط. د.ت).
292. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، (تحقيق: مؤسسة آل البيت^، ط1، قم، المؤتمر العالمي لألفيّة الشيخ المفيد، 1413هـ/1993م).
293. الإفصاح، (تحقيق: مؤسسة البعثة، بيروت، دار المفيد للطباعة، 1414هـ/1993).
294. تصحيح اعتقادات الإمامية، (تحقيق: حسين درگاهي، ط2، بيروت، دار المفيد، 1414هـ/1993م).
295. الجمل، (قم، مكتبة الداوري، د.ت).
296. حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورّث، (ط2، بيروت، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، 1414هـ/1993م).
* المقدسي، المطهّر بن طاهر (ت355هـ/966م).
297. البدء والتاريخ، (نشر مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، د.ت).
* المقدسي، أبو عبد الله محمّد بن أحمد المقدسي البشاري (ت381هـ/991م).
298. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، (ط3، بيروت، دار صادر، 1991م).
* المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت845هـ/1441م).
299. اتّعاظ الحنفاء بأخبار الأئمّة الفاطميّين الخلفاء، (تحقيق: جمال الدين الشيال، ط1، القاهرة، كلية دار العلوم، د.ت).
300. إمتاع الأسماع، (تحقيق: محمّد عبد الحميد، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ/1999م).
301. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، (ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م).
* المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين (ت1031هـ/1621م).
302. فيض القدير في شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير، (تحقيق: أحمد عبد السلام، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1415هـ/1994م).
* المنجم، إسحاق بن الحسين (من أعلام ق 4هـ).
303. آكام المرجان في ذكرى المدائن، (ط1، بيروت، عالم الكتب، 1408هـ/1988م).
* المنقري، نصر بن مزاحم (ت212هـ/827م).
304. وقعة صفّين، (تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، ط2، د.م، المؤسسة العربية الحديثة، 1382هـ/1962م).
* المهلبي، الحسن بن أحمد العزيزي (ت380هـ/990م).
305. المسالك والممالك، (تحقيق: تيسير خلف، د.م، د.ط، د.ت).
* الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمّد النيسابوري (ت518هـ/1124م).
306. مجمع الأمثال، (قم، المعاونية الثقافية للآستانة الرضوية المقدّسة، د.ت).
* النجاشي، أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي الأسدي الكوفي (ت450هـ/1058م).
307. فهرست أسماء مصنّفي الشيعة (رجال النجاشي)، (تحقيق: موسى الشبيري الزنجاني، ط5، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، 1416هـ/1995م).
* النحاس، أبو جعفر (338هـ/949م).
308. معاني القرآن، (تحقيق: محمّد علي الصابوني، ط1، المملكة العربية السعودية، جامعة أمّ القرى، 1409هـ/1988م).
* النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت303هـ/915م).
309. السنن الكبرى، (تحقيق: عبد الغفّار سليمان البنداري وسيّد كسروي حسن، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1411هـ/1991م).
* النعمان المغربي، أبو حنيفة النعمان بن محمّد التميمي القاضي (ت363هـ/ 974م).
310. دعائم الإسلام، (تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، مصر، دار المعارف، 1383هـ/1963م).
311. شرح الأخبار في فضائل الأئمّة الأطهار، (تحقيق: محمّد الحسيني الجلالي، ط2، قم، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، 1414هـ/1990م).
* النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي النووي الشافعي (676هـ/1277 م).
312. شرح صحيح مسلم، (بيروت، دار الكتاب العربي، 1407/1987م).
313. المجموع، (د.ط، د.م، د.ت).
* النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت733هـ/1333م).
314. نهاية الأرب في فنون الأدب، (القاهرة، مطابع كوستاتسوماس وشركاه، د.ت).
* الهروي، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي (ت611هـ/1214م).
315. الإشارات إلى معرفة الزيارات، (ط1، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 1423هـ/2002م).
* الهلالي، سليم بن قيس العامري (ت حوالي 90هـ/708م).
316. كتاب سليم بن قيس، (تحقيق: محمّد باقر الأنصاري، ط2، بيروت، دار الأضواء، 1430هـ/2009م).
* الهمذاني، الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت334هـ/945م).
317. صفة جزيرة العرب، (تحقيق: محمّد بن علي الأكرع، صنعاء، مكتبة الإرشاد، 1990م).
* الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت807هـ/1405م).
318. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (بيروت، دار الكتب العلمية، 1408هـ/1988م).
319. موارد الظمآن، (تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، ط1، د.م، دار الثقافة العربية، 1411هـ/1990م).
* الواقدي، محمّد بن عمر بن واقد (ت207هـ/823م).
320. فتوح الشام، (بيروت، دار الجيل، د.ت).
321. المغازي، (تحقيق: مارسدن جونس، د.م، دانش إسلامي، 1405هـ/1984م).
* اليافعي، أبو محمّد عبد الله بن سعد بن علي بن سليمان اليمني المكّي (ت768هـ /1366م).
322. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، (تحقيق: خليل المنصور، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1414هـ/1993م).
* اليعقوبي، أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت292هـ/ 904م).
323. البلدان، (تحقيق: محمّد أمين فناوي، بيروت، دار الكتب العلمية، 1422هـ/2002م).
324. تاريخ اليعقوبي، (بيروت، دار صادر، د.ت).
* أبو العرب، محمّد بن أحمد بن تميم التميمي (ت333هـ/944م).
325. كتاب المحن، (تحقيق: يحيى وهيب الجبوري، د.م، دار الغرب الإسلامي، د.ت).
* أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود (ت732هـ/1331م).
326. تقويم البلدان، (باريس، د.ط، 1266هـ/1850م).
327. المختصر في أخبار البشر، (بيروت، دار المعرفة، د.ت).
* أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين (ت356هـ/966م).
328. الأغاني، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت).
329. مقاتل الطالبيين، (تحقيق: كاظم المظفر، ط2، النجف، المكتبة الحيدرية، 1385هـ/1965م).
* أبو الفضل، محمّد بن مكرم بن علي (ت711هـ/1311م).
330. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، (تحقيق: روحية النحاس وآخرون، ط1، دمشق، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، 1402هـ/1984م).
* أبو شيبة، عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفي (ت235هـ/849م).
331. المصنّف، (تحقيق: سعيد الحليم، ط1، بيروت، دار الفكر، 1410هـ/ 1989م).
* أبو عبيدة، معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري النحوي (ت209هـ/ 824م).
332. أيّام العرب قبل الإسلام، (تحقيق: عادل جاسم البياتي، ط1، مصر، عالم الكتب، د.ت).
* أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد الغامدي الأزدي (ت157هـ/773م).
333. مقتل الحسين، (تحقيق: حسين الغفاري، قم، المطبعة العلمية، د.ت).
334. مقتل الحسين ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء (مقتل أبي مخنف)، (د.م، دار الزهراء، 1428هـ/2007م).
* أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل (ت395هـ/1005م).
335. الأوائل، (ط1، طنطا، دار البشير، 1408هـ/1988م).
336. جمهرة الأمثال، (تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، ط2، بيروت، دار الجيل، 1384هـ/1964م).
337. معجم الفروق اللغوية، (تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1412هـ/1991م).
* أبو يعلى، أحمد بن علي بن المثنّى التميمي (ت307هـ/919م).
338. مسند أبي يعلى، (تحقيق: حسين سليم أسد، د.م، دار المأمون للتراث، د.ت).
* خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت240هـ/854م).
339. تاريخ خليفة بن خياط، (تحقيق: سهيل زكار، بيروت، دار الفكر، 1414هـ/1993م).
340. الطبقات، (تحقيق: سهيل زكار، بيروت، دار الفكر، 1414هـ/ 1993م).
* درهم، الفضيل بن زبير بن عمر الرسان (كان حيا سنة 145هـ/762م).
341. تسمية مَن قُتِل مع الحسين× من ولده وإخوته وأهل بيته وشيعته، (تحقيق: محمّد رضا الحسيني، قم، 1405هـ/1984م).
* زيد الشهيد، زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت122هـ/ 739م).
342. مسند زيد، (بيروت، دار مكتبة الحياة، د.ت).
* سبط ابن العجمي، برهان الدين الحلبي (ت841هـ/1437م).
343. الكشف الحثيث عمّن رُمي بوضع الحديث، (تحقيق: صبحى السامرائي، ط1، بيروت، مكتبة النهضة العربية، 1407هـ/1987م).
* سبط بن الجوزي، شمس الدين يوسف بن فرغلي البغدادي (ت654هـ/ 1256م).
344. تذكرة الخواص من الأمّة بذكر خصائص الأئمّة، (قم، الشريف الرضي، 1418هـ/1998م).
* عبد الملك النيسابوري، بن محمّد بن إبراهيم الخركوشي، أبو سعد (ت407هـ/1017م).
345. شرف المصطفى، (ط1، مكّة، دار البشائر الإسلامية، 1424هـ/ 2004م).
* فرات الكوفي، أبو القاسم فرات بن إبراهيم (من أعلام ق4هـ/ق11م).
346. تفسير فرات الكوفي، (تحقيق: محمّد كاظم المحمودي، ط1، طهران، مؤسسة الطبع والنشر، 1410هـ/1990م).
* مجهول، (ت372هـ/982 م).
347. حدود العالم من المشرق إلى المغرب، (تحقيق: يوسف الهادي، القاهرة، الدار الثقافية، 1423هـ/2002م).
* محبّ الدين الطبري، أحمد بن عبد الله (ت694هـ/1295م).
348. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، (القاهرة، مكتبة القدسي، 1356هـ/1936م).
349. الرياض النضرة في مناقب العشرة، (بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت).
* مسلم، أبو الحسين بن الحجّاج القشيري (ت261هـ/874م).
350. صحيح مسلم، (بيروت، د.ط، 1421هـ/2000م).
* وكيع، محمّد بن خلف بن حيان (ت306هـ/919 م).
351. أخبار القضاة، (بيروت، عالم الكتب، د.ت).
* ياقوت، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت626هـ/1228م).
|
* ابن إدريس، عبد الله بن عبد العزيز. 352. مجتمع المدينة في عهد الرسول’، (الرياض، نشر جامعة الملك سعود، 1402هـ/1982م). |
|
* أبو حبيب، سعدي. 353. القاموس الفقهي، (ط2، دمشق، دار الفكر، 1408هـ/1988م). |
|
* أبو سعيدة، حسين. 354. هكذا أنتِ يا بطلة كربلاء فكر جهادي انقدح من مدرسة عاشوراء، (ط3، مؤسسة المكتبة الوثائقية، 1424هـ/2003م). |
|
* أبو كف، أحمد. 355. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مصر، (القاهرة، دار المعارف، 1119هـ/1708م). |
|
* آل درويش، عبدالله بن الحاج حسن. 356. المجالس العاشورية في المآتم الحسينية، (ط1، قم، مطبعة ستاره، 1428هـ/2007م). |
|
* آل شبيب، تحسين. 357. مرقد الإمام الحسين×، (ط1، قم، شريعت، 1421هـ/2001م). |
|
* آل عكله، طاهر حسين. 358. رأس الحسين مَن احتزّه مَن طاف به اين دُفِن، (ط1، بيروت، دار الإسلام، 1430هـ/2009م). |
|
* آل ياسين، راضي. 359. صلح الحسن، (د.م، د.ط، د.ت). |
|
* الأحمدي، علي الميانجي. 360. السجود على الأرض، (ط4، بيروت، مركز جواد للصف والطباعة والنشر والتوزيع، 1414هـ/1993م). 361. مواقف الشيعة، (ط1، د.م، مؤسسة النشر الإسلامية، 1416هـ/ 1995م). |
|
* الأردبيلي، محمّد بن علي (ت1101هـ/1689م). 362. جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والأسناد، (د.ط، مكتبة المحمدي، د.ت). |
|
* الآلوسي، محمود شكري. 363. بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب، (شرح: محمّد بهجت الأثري، ط1، القاهرة، دار الكتاب العربي، 1314هـ/1896م). 364. تفسير الآلوسي، (د.م، د.ط، د.م). |
|
* الأمين، محسن بن عبد الكريم بن علي الحسيني العاملي. 365. أعيان الشيعة، (تحقيق: حسن الأمين، ط5، بيروت، دار التعارف، 1421هـ/2000م). 366. لواعج الأشجان في مقتل الحسين، (صيدا، مطبعة العرفان، منشورات مكتبة بصيرتي، (1331هـ/1913م). |
|
* الأميني، عبد الحسين بن أحمد النجفي (ت1392هـ/1971م). 367. الغدير في الكتاب والسنّة والأدب، (ط4، بيروت، دار الكتاب العربي، 1397هـ/1977م). |
|
* البحراني، عبد العظيم المهتدي. 368. من أخلاق الإمام الحسين، (ط1، بيروت، انتشارات الشريف الرضي، 1421هـ/2000م). |
|
* البحراني، عبد الله بن نور الأصفهاني (ت1130هـ/1717م). 369. عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، الإمام الحسين×، (ط1، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي، قم، مطبعة أمير، 1407هـ/1986م). |
|
* البحراني، هاشم بن سليمان بن إسماعيل (ت1107هـ/1695م). 370. البرهان في تفسير القرآن، (تحقيق: الدراسات الإسلامية، قم، د.ط، د.ت). 371. مدينة المعاجز، (تحقيق: عزّة الله المولائي الهمداني، قم، مطبعة بهمن، 1413هـ/1992م). |
|
* البحراني، يوسف بن أحمد (ت1186هـ/1772م). 372. الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية، (تحقيق: شركة دار المصطفى’ لإحياء التراث، ط1، بيروت، نشر، شركة دار المصطفى’ لإحياء التراث، 1423هـ/2002م). |
|
* البراقي، حسن بن أحمد النجفي (ت1322هـ/1904م). 373. تاريخ الكوفة، (تحقيق: ماجد أحمد العطيّة، ط1، النجف، المكتبة الحيدرية، 1424هـ/2003م). |
|
* البروجردي، حسين الطباطبائي. 374. جامع أحاديث الشيعة، (قم، المطبعة العلمية، 1399هـ/1978م). |
|
* البروجردي، علي أصغر بن محمّد شفيع الجابلقي (ت1313هـ/1896م). 375. طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، (تحقيق: مهدي الرجائي، ط1، قم، مكتبة المرعشي النجفي، 1410هـ/1990م). |
|
* البغدادي، إسماعيل باشا (ت1339هـ/1920م). 376. هدية العارفين وآثار المصنّفين، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، د.ت). |
|
* البغدادي، عبد القادر بن عمر (ت1093هـ/1682م). 377. خِزانة الأدب، (تحقيق: محمّد نبيل طريفي، إميل بديع يعقوب، ط4، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1417هـ/1997م). |
|
* البياتي، جعفر. 378. الأخلاق الحسينية، (ط1، مطبعة مهر، أنوار الهدى، 1418هـ/ 1997م). |
|
* البيّومي، محمّد. 379. الإمامة وأهل البيت^، (ط2، مطبعة نهضت، 1415هـ/ 1995م). 380. السيّدة فاطمة الزهراء×، (ط2، مطبعة سفير أصفهان، 1418هـ/ 1997م). |
|
* الترمانيني، عبد السلام. 381. الرقّ ماضيه وحاضره، (د.م، عالم المعرفة، 1341هـ/1923م). |
|
* التستري، محمّد تقي. 382. قاموس الرجال، (ط1، قم، د.ط، 1419هـ/1998م). |
|
* التفرشي، مصطفى بن الحسين الحسيني (ت ق11). 383. نقد الرجال، (تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط1، قم، ستارة، 1418هـ/1997م). |
|
* التميمي، محمّد علي جعفر. 384. مدينة النجف، (ط1، مطبعة دار النشر والتأليف في النجف، 1372هـ/1952م). |
|
* التوني، محمّد شوكت. 385. محمّد محرّر العبيد، (القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، د.ت). |
|
* الجابري، محمّد عابد. 386. العقل السياسي العربي محدّداته وتجلّياته، (ط1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1410هـ/1990م). |
|
* الجلالي، محمّد حسين الحسيني. 387. فهرست التراث، (ط1، منشورات دليل، 1432هـ/2011م). |
|
* الجواهري، محمّد حسن النجفي (ت1266هـ/1849م). 388. جواهر الكلام، (تحقيق: عباس القوچاني، ط2، طهران، خورشيد، دار الكتب العلمية، د.ت). |
|
* الجواهري، محمّد. 389. المفيد من معجم رجال الحديث، (ط2، قم، المطبعة العلمية، 1424هـ/2003م). |
|
* الحاج، محمّد حسين. 390. حقوق آل البيت^ في الكتاب والسنّة باتّفاق الأمّة، (ط1، قم، مطبعة مهر، 1415هـ/1994م). |
|
* الحائري، جعفر عباس. 391. بلاغة الإمام علي بن الحسين÷، (تحقيق: جعفر عباس الحائري، ط1، دار الحديث، 1425هـ/2004م). |
|
* الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن (ت1104هـ/1692م). 392. وسائل الشيعة، (تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط2، قم، مطبعة مهر، 1414هـ/1994م). |
|
* الحسن، عبد الله. 393. ليلة عاشوراء في الحديث والأدب، (ط1، قم، مطبعة بهمن، 1418هـ/1997م). |
|
* الحسني، نبيل. 394. سبايا آل محمّد| دراسة في تاريخ سبي النساء وعلّة إخراج الإمام الحسين× عياله إلى كربلاء، (ط1، كربلاء، العتبة الحسينية المقدّسة، 1433هـ/2012م). |
|
* الحسون، محمّد. 395. أعلام النساء المؤمنات، (ط2، إيران، دار الأسوة، 1321هـ/ 1903م). |
|
* الحصونة، رائد حمود. 396. حياة السيّدة أسماء بنت عميس الخثعمية دراسة تاريخية، (ط1، دمشق، مطبعة تمّوز، 1435هـ/2014م). |
|
* الحكيم، حسن عيسى. 397. خطط كربلاء في فكر الإمام الصادق× (83 ـ 148 هـ)، (د.ط، 1425هـ/2004م). |
|
* الحكيم، زهير بن علي. 398. مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف، (ط1، مطبعة ظهور، نشر أهل الذكر، 1425هـ/2005م). |
|
* الحلبي، برهان الدين (ت1044هـ/1635م). 399. السيرة الحلبية، (بيروت، دار المعرفة، 1400هـ/1980م). |
|
* الحلبي، كامل بن حسين بن محمّد بن مصطفى البالي الحلبي (ت1351هـ/ 1932م). 400. نهر الذهب في تاريخ حلب، (ط2، حلب، دار القلم، 1419هـ/ 1998م). |
|
* الحلو، محمّد علي بن يحيى. 401. عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة، (مراجعة: الشيخ عبّاس الساويز الكاشاني، قم، مؤسسة السبطين العالمية، 1423هـ/ 2003م). |
|
* الحيني، محمّد جابر. 402. دراسات إسلامية في القرآن الكريم، (ط1، القاهرة، دار المعرفة، 1385هـ/1966م). |
|
* الخراساني، محمّد تقي النقوي القايني. 403. مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة، (طهران، مكتبة المصطفوي، د.ت). |
|
* الخضري، محمّد. 404. الدولة الأموية، (بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، 1415هـ/ 1995م). |
|
* الخوئي، أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم تاج الدين الموسوي (ت1413هـ/ 1992م). 405. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، (ط5، 1413هـ/ 1992م). |
|
* الدربندي، آغا بن عابد الشيرواني الحائري (ت1258هـ/1868م)، 406. إكسير العبادات في أسرار الشهادات، (تحقيق: محمّد جمعة هادي وعبّاس ملا الجمري، ط1، بيروت، دار الصفوة، 1429هـ/ 2009م). |
|
* الربيعي، عبّاس. 407. أطلس الحسين، (ط1، بغداد، هيئة تراث الشهيد الصدر، 1432هـ/2010م). |
|
* الريشهري، محمّد. 408. أهل البيت^ في الكتاب والسنّة، (قم، دار الحديث، 1375هـ/ 1955م). |
|
* الزبيدي، محبّ الدين أبو الفيض محمّد بن محمّد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي (ت1205هـ/1791م). 409. تاج العروس من جواهر القاموس، (تحقيق: علي شيري، بيروت، دار الفكر، 1414هـ/1994م). |
|
* الزركلي، خير الدين. 410. الأعلام، (ط2، القاهرة، د. ط، 1978م). |
|
* الزنجاني، إبراهيم. 411. وسيلة الدارين في أنصار الحسين، (ط1، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1395هـ/1975م). |
|
* السبحاني، جعفر. 412. أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتاريخهم، (ط1، قم، 1421هـ/2000م). |
|
* السعيدي، محمّد عبد الغني ادريس. 413. من كربلاء إلى دمشق رحلة سبايا آل بيت المصطفى’ 61هـ/ 680م شواهد تاريخية، (ط1، بغداد، دار الأضواء، 1435هـ/ 2014م). |
|
* السماوي، محمّد بن طاهر. 414. إبصار العين في أنصار الحسين، (تحقيق: محمّد جعفر الطبسي، قم، مركز الدراسات الإسلامية، د.ت). |
|
* السويدي، عبد الله بن حسين بن مرعي بن ناصر الدين البغدادي، أبو البركات (ت1174هـ/1760م). 415. النفحة المسكيّة في الرحلة المكّيّة، (أبو ظبي، المجمع الثقافي، 1424هـ/2003م). |
|
* الشابي، قتيبة (ت1429هـ/2008م). 416. معجم دمشق التاريخي للأماكن والأحياء والمشيّدات ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرِّخين، (دمشق، منشورات وزارة الثقافة د.ت). |
|
* الشاكري، حسين. 417. الأعلام من الصحابة والتّابعين، (ط2، ستارة، 1418هـ/ 1997م). 418. العقيلة والفواطم، (قم، مطبعة ستارة، د.ت). |
|
* الشاهرودي، علي النمازي (ت1405هـ/1984م). 419. مستدرك سفينة البحار، (تحقيق: حسن بن علي النمازي، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، 1418هـ/1997م). 420. مستدركات علم رجال الحديث، (ط1، طهران، مطبعة الشفق، 1412هـ/1991م). |
|
* الشاوي، علي. 421. مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة، الإمام الحسين في المدينة، (إيران، مركز الدراسات الإسلامية، 1382هـ/1962م). |
|
* الشبراوي، عبد الله بن محمّد بن عامر. 422. الإتحاف بحبّ الأشراف، (تحقيق: سامي الغريري، ط1، مؤسسة الكتاب الإسلامي، 1423هـ/2002م). |
|
* الشبلنجي، مؤمن بن حسن مؤمن (ت ق 13). 423. نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار صلى الله عليه وسلم، (د.م، مركز العلوم الإسلامي، د.ت). |
|
* الشريف، أحمد إبراهيم. 424. مكّة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول’، (دار الفكر، د.ت). |
|
* الشهرستاني، هبة الدين (ت1386هـ/1967م). 425. نهضة الحسين×، (قدّم له: علي الخاقاني، ط5، كربلاء، رابطة النشر الإسلامي، مطبعة دار التضامن، 1388هـ/1958م). |
|
* الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي (ت965هـ/1557م). 426. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام (تحقيق: مؤسسة المعارف الإسلامية، ط1، قم، بهمن، 1413هـ/1992م). |
|
* الشوكاني، محمّد بن علي بن محمّد (ت1255هـ/1839م). 427. نيل الأوطار، (بيروت، دار الجيل، 1073م). |
|
* الشيرازي، علي خان المدني (ت1120هـ/1709م). 428. الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، (تقديم: محمّد صادق بحر العلوم، قم، منشورات مكتبة بصيرتي، 1397هـ/1976م). 429. رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين×، (تحقيق: محسن الحسيني الأميني، ط4، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415هـ/ 1995م). |
|
* الصابوني، محمّد علي. 430. صفوة التفاسير، (ط1، القاهرة، نشر دار الصابوني، 1417هـ/ 1997م). |
|
* الطباطبائي، علي (ت1231هـ/1816م). 431. رياض المسائل، (تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1412هـ/1992م). |
|
* الطباطبائي، محمّد حسين (ت1402هـ/1982م). 432. الميزان في تفسير القرآن، (قم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.ت). |
|
* الطبرسي، حسين النوري (ت1320هـ/1902م). 433. خاتمة مستدرك الوسائل، (تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط1، قم، 1408هـ/1987م). |
|
* الطبسي، نجم الدين. 434. الأيّام المكّية من عمر النهضة الحسينية، (ط1، بيروت، دار الولاء، 1423هـ/2002م). |
|
* الطريحي، فخر الدين النجفي (ت1085هـ/1676م). 435. مجمع البحرين ومطلع النيرين، (تحقيق: أحمد الحسيني، ط2، قم، نشر مرتضوي، د.ت). 436. المنتخب في جمع المراثي والخطب، (ط1، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1434هـ/2003م). |
|
* العاملي، بهاء الدين محمّد بن الحسين (ت1031هـ/1621م). 437. توضيح المقاصد، (د.ط، قم، مطبعة الصدر، مكتب آية الله العظمى المرعشي، 1406هـ/1985م). |
|
* العاملي، جعفر مرتضى. 438. الصحيح من سيرة النبي الأعظم’، (ط1، قم، دار الحديث للطباعة والنشر، 1426هـ/2005م). 439. عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني، (ط1، بيروت، المركز الإسلامي للدراسات، 1424هـ/2003م). |
|
* العزّاوي، خالد عبد الرزّاق مهدي. 440. البريد في التاريخ، (ط1، بغداد، المكتبة الوطنية، 1425هـ/ 2004م). |
|
* العسكري، مرتضى. 441. أحاديث أمّ المؤمنين عائشة، (ط5، مطبعة صدر، نشر التوحيد، 1414هـ/1994م). 442. معالم المدرستين (بيروت، مؤسسة النعمان، 1410هـ/1990م). 442. |
|
* العقّاد، عبّاس محمود. 443. أبو الشهداء الحسين بن علي، (تحقيق: محمّد جاسم الساعدي، طهران، د.ط. 1425هـ/2004م). 444. معاوية بن أبي سفيان، (د.م، دار الصدى، د.ت). |
|
* العلوي، محمّد بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى (ت1350هـ/1931م). 445. النصائح الكافية لِمَن يتولّى معاوية، (ط1، قم، دار الثقافة، 1412هـ/1991م). |
|
* العلي، صالح أحمد. 446. الكوفة وأهلها في صدر الإسلام، (بيروت، شركة المطبوعات، د.ت). |
|
* العمري، ياسين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب (ت1232هـ/ 1816م). 447. الروضة الفيحاء في أعلام النساء، (د.م، د.ط، د.ت). |
|
* الفتني، محمّد طاهر بن علي الهندي (ت986هـ/1578م). 448. تذكرة الموضوعات، (د.ط، د.م، د.ت). |
|
* الفضلي، عبد الهادي. 449. خلاصة المنطق، (قم، ط3، مطبعة محمّد، 1428هـ/2007م). |
|
* القبانچي، حسن. 450. مسند الإمام علي×، (تحقيق: الشيخ طاهر السلامي، ط1، بيروت، الأعلمي، 1421هـ/2000م). |
|
* القرشي، باقر شريف. 451. حياة الإمام الحسن بن علي، (دار الكتب العلمية، ط3، قم، 1973م). 452. حياة الإمام الحسين، (ط1، بيروت، دار البلاغة، 1394هـ/1974م). 453. السيّدة زينب‘ بطلة التاريخ ورائدة الجهاد في الإسلام، (دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 1998م). |
|
* القزويني، رضا بن نبي. 454. تظلّم الزهراء، (بيروت، د.ط، 1420هـ/1999م). |
|
* القزويني، محمّد كاظم. 455. زينب الكبرى‘ من المهد إلى اللحد، (ط1، بيروت، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات، 1427هـ/2007م). |
|
* القطيفي، فرج آل عمران 456. وفاة زينب الكبرى، (د.ط، النجف، 1378هـ/1959م). |
|
* القمّي، عبّاس (ت1359هـ/1940م). 457. الكُنى والألقاب، (تقديم: هادي الأميني، طهران، مكتبة الصدر، د.ت). 458. منتهى الآمال في تواريخ النبي والآل، (بيروت، الدار الإسلامية، 1414هـ/1994م). 459. نَفَس المهموم، (دار المحجّة البيضاء، دار الرسول الأكرم’، د.ت). |
|
* القندوزي، سليمان بن إبراهيم الحنفي (ت1294هـ/1877م). 460. ينابيع المودّة لذوي القربى، (تحقيق: علي جمال أشرف الحسيني، ط1، قم، دار الأسوة، 1416هـ/1996م). |
|
* الكاشاني، محمّد بن محسن (الفيض الكاشاني) (ت1091هـ/1680م). 461. الوافي، (تحقيق: ضياء الدين الحسيني، ط1، أصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي×، 1406هـ/1986م). |
|
* الكتاني، محمّد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمّد الحسني الإدريسي (ت1382هـ/ 1963م). 462. التراتيب الإدراية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنوّرة، (تحقيق: عبد الله الخالدي، ط2، بيروت، د.ت). |
|
* الكعبي، عبد الزهرة. 463. مقتل الحسين ومسير السبايا، (د.م، شبكة الفكر، 1418هـ/ 1997م). |
|
* الكوراني، علي العاملي. 464. الإنتصار، (ط1، بيروت، دار المسيرة، 1422هـ). 465. جواهر التاريخ، (ط1، قم، مطبعة شريعت، 2004م). 466. قبيلة بني أسد بن خزيمة، (شارك فيه: عبد الهادي الربيعي، ط1، 1413هـ/2010م). |
|
* المازندراني، أبو علي محمّد بن إسماعيل الحائري (ت1216هـ/1801م). 467. منتهى المقال، (تحقيق: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التّراث، ط1، قم، مؤسسة آل البيت^، 1416هـ/1996م). |
|
* المازندراني، محمّد مهدي الحائري. 468. معالي السبطين، (ط1، بيروت، مؤسسة البلاغ، 2011م). |
|
* المامقاني، عبد الله (ت1351هـ/1932م). 469. الفوائد الرجالية في تنقيح المقال، (تحقيق: محمّد رضا المامقاني، ط1، قم، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، 1431هـ/2009م). |
|
* المتّقي الهندي، علاء الدين بن علي (ت975هـ/1567م). 470. كنز العمّال في سنن الأقوال والأفعال، (تحقيق: بكري حياتي، تصحيح: صفوة السقّا، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1409هـ/ 1989م). |
|
* المحلّاتي، ذبيح الله. 471. رياحين الشريعة في ترجمة علامات نساء الشيعة، (طهران، دار الكتب الإسلامية، 1370هـ/1951م). 472. فرسان الهيجاء في تراجم أصحاب سيّد الشهداء، (تحقيق: محمّد شعاع فاخر، ط1، النجف، المكتبة الحيدرية، 2008م). |
|
* المحمودي، محمّد باقر. 473. ترجمة ريحانة رسول الله’ الإمام الحسين× من تاريخ مدينة دمشق، (تحقيق: محمّد باقر المحمودي، ط2، قم، فروردين، 1414هـ/ 1993م). |
|
* المرعشي، نور الله الحسيني التستري (ت906هـ/1610م). 474. إحقاق الحقّ وإزهاق الباطل، (قم، مكتبة المرعشي النجفي، د.ت). |
|
* المطهري، مرتضى. 475. الملحمه الحسينية، (قم، مطبعة إسماعيليان، 1992م). |
|
* المظفّر، عبد الواحد. 476. البطل الأسدي حبيب بن مظاهر، (د.م، مكتبة دار الانصار، 2002م). |
|
* المقرّم، عبد الرزاق الموسوي (ت1391هـ/1972م). 477. السيّدة سكينة بنت الحسين، (ط2، النجف، المطبعة الحيدرية، 1949م). 478. علي الأكبر، (النجف، المكتبة الحيدرية، 1408هـ/1988م). 479. مقتل الحسين×، (ط4، النجف، مطبعة الآداب، د.ت). |
|
* المهاجر، جعفر. 480. موكب الأحزان (سبايا آل البيت^)، (ط1، بهاء الدين العاملي للطباعة والنشر، د.ت). |
|
* الموسوي، عبد الحسين شرف الدين (ت1377هـ/1957م). 481. الفصول المهمّة، (تحقيق: حسين الراضي، ط1، د.م، قسم الإعلام الخارجي مؤسسة البعثة، 1423هـ/2002م). 482. النصّ والاجتهاد، (تحقيق: أبو مجتبى، ط1، قم، سيّد الشهداء×، 1404هـ/1984م). |
|
* النصر الله، جواد كاظم. 483. فضائل أميرالمؤمنين× المنسوبة لغيره ـ الحلقة الأولى: الولادة في الكعبة، (ط1، النجف، مركز الأبحاث العقائدية، 2009م). |
|
* النصراوي، حسين عبد الأمير. 484. رأس الحسين× من الشهادة إلى الدفن، (ط1، بيروت، د.ط، 2000م). |
|
* النفيس، أحمد راسم. 485. على خطى الحسين×، (ط1، مطبعة فروردين، نشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية، 1418هـ/1997م). |
|
* النقدي، جعفر. 486. الأنوار العلوية، (ط2، النجف، المطبعة الحيدرية، 1381هـ/ 1962م). 487. زينب الكبرى بنت الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب× وفاطمة بنت الحسين×، (ط1، بيروت، دار جواد الأئمّة×، 1432هـ/ 2011م). |
|
* الهندي، بهاء الدين محمّد بن الحسن الأصفهاني (الفاضل الهندي) (ت1137هـ/ 1724م). 488. كشف اللثام (تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1416هـ/1995م). |
|
* أمانة مسجد النخيلة التاريخي. 489. النخيلة المسجد والمزار، (ط1، النجف الأشرف، الضياء، 1434هـ/2013م). |
|
* أيوب، سعيد. 490. معالم الفتن، (ط1، مطبعة سمهر، 1416هـ/1995م). |
|
* بارا، أنطوان. 491. الحسين في الفكر المسيحي، (ط1، الكويت، دار العلوم، 1398هـ/1978م). |
|
* بحر العلوم، محمّد (ت1436هـ/2015 م). 492. في رحاب السيّدة زينب، (ط1، بيروت، د.ط، 1395هـ/ 1975م). |
|
* بدران، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمّد (ت1346هـ/ 1927م). 493. منادمة الأطلال ومسامرة الخيال، (تحقيق: زهير الشاويش، ط2، بيروت، المكتب الإسلامي، 1405هـ/1985م). |
|
* بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن. 494. تراجم سيّدات بيت النبوّة، (د.م، دار الريان للتراث، د.ت). |
|
* جعيط، هشام. 495. الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكّر، (ترجمة: خليل أحمد خليل، بيروت، مكتبة طريق العلم، د.ت). |
|
* حرز الدين، محمّد. 496. مراقد المعارف، (ط1، مطبعة مهر، منشورات سعيد بن جبير، 1371هـ/1992م). |
|
* حريري، علي. 497. الأخبار السنية في الحروب الصليبية، (ط2، مطبعة مصر، 1329هـ/1329م). |
|
* حسن، علي إبراهيم. 498. نساء لهنَّ في التاريخ الإسلامي نصيب، (مصر، مكتبة النهضة المصرية، 1390هـ/1970م). |
|
* خليفة، حاجي (ت1067هـ/1656م). 499. كشف الظنون، (بيروت، دار إحياء التراث، د.ت). |
|
* درنيقة، محمّد أحمد. 500. معجم أعلام شعراء المدح النبوي، (تحقيق: ياسين الأيوبي، ط1، د.م، دار الهلال، 2003م). |
|
* ديورانت، ول. 501. قصّة الحضارة، (د.م، المنظّمة العربية للتربية والثقافة، د.ت). |
|
* رستوفتزف. 502. تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي، (ترجمة: زكي علي ومحمّد سليم، مصر، مكتبة النهضة المصرية). |
|
* سالم، عبد العزيز. 503. تاريخ الدولة العربية تاريخ العرب منذ عصر الجاهلية حتى سقوط الدولة الأموية، (بيروت، دار النهضة العربية). |
|
* ساليفان، ريتشارد 504. ورثة الإمبراطورية الرومانية الغرب الجرماني، العالم الإسلامي ـ الدولة البيزنطية، (ترجمة: جوزيف نسيم يوسف، ط1، مكتبة التاريخ الوسيط، نشر، مؤسسة شباب الجامعة، 1406هـ/1985م). |
|
* سبهر، محمّد تقي لسان الملك. 505. ناسخ التواريخ حياة الإمام سيّد الشهداء، (تحقيق: علي جمال أشرف، ط1، قم، نشر مدين، 1327هـ/2007م). |
|
* سركيس، اليان (ت1351هـ/1932م). 506. معجم المطبوعات العربية، (قم، مطبعة بهمن، 1410هـ/1990م). |
|
* سعيد، محمّد. 507. الديارات والأمكنة النصرانية في الكوفة وضواحيها، (د.ط، بيروت، 1400هـ/1980م). |
|
* شفيق، أحمد. 508. الرقّ في الإسلام، (ترجمة: أحمد زكي، ط1، القاهرة، المطبعة الأهلية، 1982م). |
|
* شلبي، أحمد. 509. التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية الدولة الأموية، (مصر، دار الإتحاد العربي للطباعة، 1978م). 510. مقارنة الأديان (الإسلام)، (ط4، القاهرة، مطبعة السنّة المحمدية، نشر مكتبة النهضة المصرية، 1392هـ/1973م). |
|
* شمس الدين، إبراهيم. 511. مجموع أيّام العرب في الجاهلية والإسلام، (بيروت، منشورات محمّد علي بيضون، دار الكتب العلمية). |
|
* شمس الدين، محمّد مهدي. 512. أنصار الحسين دراسة عن شهداء ثورة الحسين الرجال والدلالات، (ط2، طهران، الدار الإسلامية، 1401هـ/1981م). |
|
* صبري، أحمد. 513. رأس الحسين تناقض العوامل الذاتية ومنهج الحراك التاريخي، (مصر، 1422هـ/2002م). |
|
* صفّار، حسن. 514. المرأة العظيمة قراءة في حياة السيّدة زينب بنت علي‘، (ط1، مؤسسة الانتشار العربي، 1421هـ/2000 م). |
|
* صفوت، أحمد زكي. 515. جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة، (ط2، القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1381هـ/1962م). |
|
* طعيمة، صابر. 516. الأباضية عقيدة ومذهباً، (د.م، دار الجيل، 1406هـ/1986م). |
|
* عابدين، محمّد أبو اليسر. 517. القول الوثيق في أمر الرقيق، (تقديم، محمّد كريم راجح، ط1، دمشق، دار البشائر، 1417هـ/1996م). |
|
* عاشور، سعيد عبد الفتّاح. 518. الحركة الصليبية، (ط2، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 1971م). |
|
* عبد الرسول، سليمة. 519. الفرق الإسلامية ذيل كتاب شرح المواقف للكرماني، (د.م، بغداد، 1393هـ/1973م). |
|
* عبد الرؤوف، عصام. 520. بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي، (دار الفكر العربي، د.ت). |
|
* عبد المنعم، محمود عبد الرحمن. 521. معجم المصطلحات والألفاظ، (القاهرة، دار الفضيلة، د.ت). |
|
* عبد الناصر، عبد الله. 522. محنة فاطمة بعد وفاة رسول الله’، (ط1، 1420هـ/1999م). |
|
* عرفانيان، غلام رضا. 523. مشايخ الثقات، (ط1، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ/ 1996م). |
|
* عرفة، محمّد سليم. 524. إفادات من ملفّات التاريخ، (ط1، قم، ستارة، 1427هـ/ 2006م). |
|
* عصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك المكّي (ت1111هـ/1699م). 525. سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، (تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمّد معوض، ط1، بيروت، دار الكتب العلمية، 1419هـ/1998م). |
|
* عطيّة، علي سعود. 526. تاريخ الحروب الصليبية، (ط1، القاهرة، الشركة العربية المتّحدة للتسويق والتوريدات، 2010م). |
|
* علي، جواد. 527. تاريخ العرب في الإسلام، (بيروت، دار الحداثة، د.ت). 528. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط2، الهيئة العامّة لمكتبة الإسكندرية، 1413هـ/1993م). |
|
* عمران، محمود سعيد. 529. معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطينية (د.م، دار المعرفة الجامعية، 2000م). |
|
* عنان، محمّد عبد الله. 530. مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام، (ط4، القاهرة، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1962م). |
|
* فريمان، جرنفيل. 531. التقويمان، (ترجمة: حسام محي الدين الآلوسي، بغداد، مطبعة الجمهورية، 1389هـ/1970م). |
|
* فلوتن، فان. 532. السيادة العربية والشيعة والإسرائيليّات في عهد بني أميّة، (ترجمة: د.حسين إبراهيم، محمّد زكي إبراهيم، ط1، 1352هـ/1934م). |
|
* قاسم، حسن محمّد. 533. تاريخ ومناقب ومآثر الست الطاهرة البتول السيّدة زينب وأخبار الزينبيّات للعبيدلي، (ط2، د.م، 1353هـ/1934م). |
|
* كاشف الغطاء، هادي. 534. الملحمة الكبرى لواقعة كربلاء، (تحقيق: جعفر باقر الحسيني، ط1، قم، أنوار الهدى، 1416هـ/1995م). |
|
* كحالة، عمر رضا. 535. أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، (ط2، دمشق، المطبعة الهاشمية، 1379هـ/1959م). |
|
* لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×. 536. موسوعة كلمات الإمام الحسين×، (ط3، دار المعروف، 1416هـ/ 1995م). |
|
* ليسترنج، كي. 537. بلدان الخلافة الشرقية، (ترجمة: بشير فرنسيس، كوركيس عواد، ط2، بيروت، مؤسسة الرسالة 1405هـ/1985م). |
|
* متز، آدم. 538. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، (ط4، بيروت، دار الكتاب العربي، 1967م). |
|
* محمد، سعاد ماهر. 539. مشهد الإمام علي في النجف وما به من الهدايا والتّحف، (مصر، دار المعارف، د.ت). |
|
* محمّد، كرد علي. 540. خطط الشام، (ط2، دمشق، مكتبة النوري، 1403هـ/1983م). |
|
* محمّد، هاشم. 541. شهيد الولاء حجر بن عدي، (ط2، مطبعة بهمن، 1419هـ/ 1998م). |
|
* مرغي، جاسم عثمان. 542. الشيعة في مصر، (ط1، مؤسسة البلاغ، دار سلوني، 1423هـ/ 2003م). |
|
* مركز المعجم الفقهي. 543. المصطلحات، (د.م، د.ط، د.ت). |
|
* مهدي، خالد عبد الرزّاق. 544. البريد في التاريخ، (ط1، بغداد، د.ط، 2004م). |
|
* مهدي، صالح. 545. الحسين قائد الإنتصار بالمظلومية (ط2، د.م، د.ت). |
|
* هنتس، فالتر. 546. المكاييل والأوزان الإسلامية، (ترجمة، د. كامل العلي، منشورات الجامعة الأردنية، د.ت). |
|
* وليست، انثوني. 547. الحروب الصليبية، (ترجمة: شكري محمود نديم، بغداد، مكتبة كلية الآداب، د.ت). |
|
* وليم، الصوري. 548. تاريخ الحروب الصليبية، (ترجمة: سهيل زكار، بيروت، دار الفكر، 1424هـ/2003م). |
|
* يعقوب، أحمد حسين. 549. كربلاء الثورة والمأساة، ( ط1، بيروت، الغدير للدراسات الإسلامية، 1418هـ/1997م). |
|
* يوسف، رزق الله بن يوسف بن عبد المسيح بن يعقوب شيخو (ت1346هـ/ 1927م). 550. شعراء النصرانية، (بيروت، مطبعة الآباء المرسلين اليسوعيين، 1307هـ/1890م). |
551. الخزل والدأل بين الدور والدارات والديرة، (تحقيق: يحيى زكريا عبارة، محمّد أديب جمران، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، 1417هـ/1997م).
552. معجم الأدباء، (ط3، بيروت، دار الفكر، 1400هـ/1979م).
553. معجم البلدان، (بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1399هـ/1979م).
ثالثاً: المراجع
|
* بيضون، لبيب. 554. موسوعة كربلاء، (بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1426هـ/ 2006م). |
|
* التهانوي، محمّد على بن علي. 555. موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية، (تحقيق: محمّد وجيه، ط1، بيروت، المكتبة الإسلامية، 1966م). |
|
* الخرسان، محمّد مهدي. 556. موسوعة عبد الله بن عبّاس، (ط1، مطبعة ستارة، نشر مركز الأبحاث العقائدية، 1428هـ/2007م). |
|
* الخليلي، جعفر. 557. موسوعة العتبات المقدّسة، (بيروت، منشورات الأعلمي، 1407هـ/1987م). |
|
* الريشهري، محمّد. 558. موسوعة الإمام الحسين في الكتاب والسنّة والتاريخ، (ط1، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، 1433هـ/2012م). 559. موسوعة الإمام علي في الكتاب والسنّة والتاريخ، (تحقيق: محمّد كاظم الطباطبائي ومحمود الطباطبائي، ط2، قم، دار الحديث، 1425هـ/2004م). |
|
* الشنشتاوي، أحمد، وآخرون. 560. دائرة المعارف الإسلامية، (راجعها: محمّد مهنّد). |
|
* كحالة، عمر رضا. 561. موسوعة مقتل الإمام الحسين، (بيروت، دار المرتضى للطباعة والنشر والتوزيع، 1429هـ/2008م). |
|
* محدّثي، جواد. 562. موسوعة عاشوراء، (ط1، بيروت، دار الرسول’ الأكرم ودار المحجّة البيضاء، 1418هـ/1997م). |
|
* مركز الأبحاث العقائدية. 563. موسوعة من حياة المستبصرين، (ط1، قم، مطبعة ستاره، مركز الأبحاث العقائدية، 1424هـ/2003م). |
خامساً: الرسائل والأطاريح الجامعية
|
* الأسدي، حيدر شمخي جابر. 564. تاريخ المُثْلة في الدولة الإسلامية حتى عام 132 هـ، رسالة ماجستير، (المستنصرية: التربية، 1436هـ/2016م). |
|
* أمير، خالد راسم. 565. حركة التوّابين 61 ـ 64هـ/680 ـ 684م دراسة تاريخية، رسالة ماجستير، (بابل، التربية، 1427هـ/2007م). |
|
* البو هلالة، حسين نعمة إبراهيم. 566. أنصار الإمام الحسين×في وقعة كربلاء من غير الهاشميين دراسة في أحوالهم العامّة، رسالة ماجستير، (البصرة، الآداب، 1430هـ/ 2009م). |
|
* بيج، أمير جواد كاظم علي. 567. الحائر الحسيني دراسة تاريخية 61 ـ 656هـ/680 ـ 1258م، رسالة ماجستير، (الكوفة، الآداب، 1426هـ/2006م). |
|
* التميمي، هادي عبد النّبي. 568. ثورة الإمام الحسين في المصنّفات المصرية في القرن العشرين الميلادي، أطروحة دكتوراه، (الكوفة، الآداب، 1427هـ/2007م). |
|
* الجابري، علي رحيم أبو الهيل. 569. السياسة الأموية المضادة للإمام علي× دراسة في سياسة السبّ، رسالة ماجستير، (البصرة، التربية، 1428هـ/2008م). |
|
* الجميلي، علي إبراهيم عبيد. 570. مسلم بن عقيل دراسة تاريخية، رسالة ماجستير، (المستنصرية، التربية، 1431هـ/2010م). |
|
* الجيزاني، رحمن حسين علي. 571. الهجرة إلى الحبشة، رسالة ماجستير، (بغداد، التربية بن رشد، 1424هـ/2004م). |
|
* الحلفي، صبيح نوري خلف. 572. نساء البيت الأموي ودورهنّ في الحياة الاجتماعية والسياسية حتى نهاية العصر الأموي، أطروحة دكتوراه، (البصرة، الآداب، 1426هـ/2006م). |
|
* حمود، خنساء مهدي. 573. خطب نساء أهل البيت^ بعد واقعة الطفّ مدّة السبي دراسة أسلوبية، رسالة ماجستير، (البصرة، الآداب، 1432هـ/2011م). |
|
* حمود، هادي حسن. 574. القُرّآء ودورهم في الحياة العامّة في صدر الإسلام والخلافة الأموية، أطروحة دكتوراه، (بغداد، الآداب، 1404هـ/1984م). |
|
* حميد، إنتهاء خالد. 575. أثر الخلافة الفاطمية في الحروب الصليبية، رسالة ماجستير، (المستنصرية، التربية، 1434هـ/2013م). |
|
* الحميدي، شيماء فاضل عبد الله. 576. البداوة قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية، رسالة ماجستير، (بغداد، التربية بن رشد، 1427هـ/2007م). |
|
* الحيالي، سفانة رعد خليل ابراهيم. 577. عبد الله بن علي 95 ـ 147هـ/713 ـ 764م سيرته ودوره السياسي والعسكري، (الموصل، التربية، 1424هـ/2004 م). |
|
* خضر، أمل محمد. 578. دور نساء آل البيت السياسي والفكري في معركة الطفّ وما بعدها، أطروحة دكتوراه، (المستنصرية، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، 1425هـ/2005م). |
|
* الدجيلي، محمّد رضا. 579. الأزارقة، رسالة ماجستير، (بغداد، الآداب، 1392هـ/1973م). |
|
* الدخيلي، مهدي عريبي. 580. بني أسد ودورهم في التاريخ العربي الإسلامي، أطروحة دكتوراه، (البصرة، الآداب، 1415هـ/1995م). |
|
* الدليمي، خالد أحمد صالح. 581. أبو سفيان صخر بن حرب سيرته وأثره السياسي في مكّة، (بغداد، التربية ابن رشد، 1423هـ/2003م). |
|
* دوفش، محمّد يوسف أحمد. 582. الابتلاء في القرآن الكريم، رسالة ماجستير، (جامعة الأردن، الشريعة، 1408هـ/1988م). |
|
* الراوي، قصي أسعد عبد الحميد. 583. آل الزبير ودورهم في الدولة العربية الإسلامية منتصف القرن الثالث الهجري، أطروحة دكتوراه، (بغداد، التربية ابن رشد، 1423هـ/2003م). |
|
* الزيدي، سامي جودة بعيد. 584. فدك حتى نهاية العصر العباسي، رسالة ماجستير، (بغداد، التربية ابن رشد، 1427هـ/2006م). |
|
* الزيدي، مروان عطيّة مايع. 585. ثورة الإمام الحسين× وأثرها على حركات المعارضة حتى عام 132هـ، (المستنصرية، التربية، 1427هـ/2007م). |
|
* السامرائي، هند يوسف مجيد. 586. دور المرأة في حركة الخوارج، رسالة ماجستير، (تكريت، التربية، 1426هـ/2005م). |
|
* سلمان، يلدز داود. 587. المستنصر بالله الفاطمي دراسة في سياسته الداخلية والخارجية 427ـ 487هـ/1035ـ1094م، رسالة ماجستير، (المستنصرية، التربية، 1429هـ/2008م). |
|
* سند، ياسمين سالم مطرود. 588. تاريخ الرسل والملوك لمحمّد بن جرير الطبري مصدراً لدراسة سيرة الإمام علي× دراسة نقدية تحليلية، رسالة ماجستير، (البصرة، الآداب، 1434هـ/2013م). |
|
* الشيخ عبد المحسن، يوسف. 589. حركة الخوارج نشأتها وأسبابها، رسالة ماجستير، (جامعة الكويت، د.ط، 1977م). |
|
* صاحب، أحمد عليوي. 590. مسيرة الإمام الحسين إلى كربلاء دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، (بغداد، الآداب، 1427هـ/2007م). |
|
* صالح، خولة عيسى محمّد. 591. نشأة البريد وتطوّره في الدولة العربية الإسلامية حتى عام 334هـ، رسالة ماجستير، (بغداد، الآداب، 1405هـ/1985م). |
|
* صالح، غصون عبد. 592. سليمان بن مهران الأعمش ومرويّاته التاريخية، رسالة ماجستير، (ديالى، التربية، 1426هـ/2006م). |
|
* الطائي، رائد محمّد حامد حسن. 593. الرقيق في صدر الإسلام والدولة الأموية، رسالة ماجستير، (الموصل، الآداب، 1422هـ/2002م). |
|
* الطائي، محمّد عبيد حميد. 594. الإمام الباقر ومرويّاته التاريخية (56 ـ 114)، رسالة ماجستير، (بابل، التربية، 1425هـ/2005م). |
|
* عبد الخالق، حنان. 595. مدينة نصيبين في العصر العباسي دراسة سياسية حضارية، رسالة ماجستير، (الموصل، الآداب، 1423هـ/2003م). |
|
* عبد الكاظم، حارس رميلي. 596. كتاب واقعة صفّين للمنقري دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، (البصرة، الآداب، 1435هـ/2014م). |
|
* عبد الواحد، فلاح شنشل. 597. الصحابي الجليل مالك بن نويرةE دراسة تاريخية، رسالة ماجستير، (المستنصرية، التربية، 1435هـ/2014م). |
|
* العبودي، هناء سعدون جبّار. 598. السيّدة زينب‘ ودورها في أحداث عصرها، رسالة ماجستير، (الكوفة، الآداب، 1426هـ/2006م). |
|
* العزّاوي، أسماء غني عبد الله. 599. نشاط الخوارج في البصرة والأحواز خلال القرن الأول الهجري، رسالة ماجستير، (بغداد، الآداب، 1421هـ/2001م). |
|
* العزّاوي، إسماعيل ذياب خليل. 600. خالد بن الوليد دراسة في شخصيّته ودوره في الإسلام، رسالة ماجستير، (بغداد، التربية ابن رشد، 1425هـ/2004م). |
|
* عطاوي، عمر فلاح عبد الجبّار. 601. أهل الصفة في عصر الرسالة والراشدي، رسالة ماجستير، (بغداد، الآداب، 1425هـ/2005م). |
|
* علوان، ستّار جبّار. 602. الأحوال السياسية والحضارية في إقليم كرمان حتى نهاية القرن الرابع الهجري، أطروحة دكتوراه، (بغداد، الآداب، 1427هـ/ 2007م). |
|
* العوّاد، إنتصار عدنان عبد الواحد. 603. السيّدة فاطمة الزهراء‘ دراسة تاريخية، رسالة ماجستير، (البصرة، الآداب، 1428هـ/2007م). |
|
* فيصل، مخلد ذياب. 604. هشام بن الحكم الكوفي ودوره في الحياة الفكرية خلال العصر العباسي الأول، رسالة ماجستير، (بابل، التربية، 1427هـ/2006م). |
|
* الفيصل، نادية محسن عزيز صالح. 605. الدور الحضاري لمدينة الرقّة في العصر العباسي 132 ـ 380هـ/749 ـ 993م، رسالة ماجستير، (الموصل، الآداب، 1424هـ/2004م). |
|
* قبلان، الحمد. 606. عبد الله بن الزبير حركته وخلافته، رسالة ماجستير، (بغداد، الآداب، 1393هـ/1973م). |
|
* الكربولي، عبد محمّد إبراهيم. 607. الجامع الأموي في دمشق وأثره في الحياة السياسية والإدارية والفكرية منذ التأسيس حتى سنة 569هـ/1173م، رسالة ماجستير، (الأنبار، الآداب، 1432هـ/2011م). |
|
* اللامي، إيمان أحمد جابر. 608. خطب وأقوال أهل البيت في واقعة الطفّ دراسة تاريخية، رسالة ماجستير، (المستنصرية، التربية، 1428/2008م). |
|
* مال الله، حيدر لفته. 609. أساليب الدولة الأموية في تثبيت السلطة (دراسة تاريخية)، أطروحة دكتواره، (البصرة، الادآب، 1432هـ/2011م). |
|
* المالك، فاطمة عبد سعيد شلّال. 610. الطلقاء دراسة في المعنى وإشكالية القراءة التاريخية، رسالة ماجستير، (البصرة، التربية، 1434هـ/2013م). |
|
* المالكي، رغد عبد النبي جعفر. 611. الرهبانية النصرانية في مصر من القرن الثالث الميلادي إلى القرن الخامس الميلادي، أطروحة دكتوراه، (بغداد، التربية ابن رشد، 1434هـ/ 2013م). |
|
* محمد، رغداء حسين. 612. حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي وأبعادها السياسية والفكرية، رسالة ماجستير، (الكوفة، الآداب، 1427هـ/2007م). |
|
* المحمّداوي، علي صالح رسن. 613. أبو طالب بن عبد المطّلب دراسة في سيرته الشخصية وموقفه من الدعوة الإسلامية، أطروحة دكتوراه، (البصرة، الآداب، 1424هـ/ 2004م). |
|
* المدغش، ناظم ظاهر. 614. دور مسلمة الفتح من قريش في الإسلام حتى نهاية العصر الراشدي، رسالة ماجستير، (بغداد، الآداب، 1424هـ/2004م). |
|
* مدقن، هاجر. 615. الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه دراسة تطبيقية في كتاب المساكين للرافعي، رسالة ماجستير، (ورقلة، الادآب، 1423هـ/ 2003م). |
|
* مدلّل، شادي إبراهيم عبد القادر. 616. السبي في صدر الإسلام، رسالة ماجستير، (فلسطين، جامعة النجاح، 1431هـ/2010م). |
|
* مزهر، ختام راهي. 617. أهل الصفة في الإسلام دراسة في أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية حتى العصر الراشدي، رسالة ماجستير، (الكوفة، الآداب، 1421هـ/2001م). |
|
* الملّا طه، حنان عبد الرحمن. 618. الديارات النصرانية في العراق ونشاطاتها العلمية والفكرية حتى نهاية العصر العباسي، رسالة ماجستير، (تكريت، التربية، 1425هـ/ 2005م). |
|
* الميّاحي، هادي عبد الكريم عبد الرضا. 619. معركة الجمل 36هـ/656م الأسباب والنتائج دراسة تاريخية، رسالة ماجستير، (كلية الدراسات التاريخية في البصرة، 1433هـ/ 2012م). |
|
* نجمان، ياسين عبّاس. 620. التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة، أطروحة دكتوراه، (الموصل، الآداب،1990م). |
|
* الجنابي، قيس حاتم هاني. 621. نشأة وتطوّر البريد في الدولة العربية الإسلامية حتى عام 86هـ، (جامعة بابل، مجلّة كليّة التربية، ع 10، 1423هـ/2003م، ص8. |
|
* الحجاج، محسن مشكل فهد. 622. طريق الإمام الحسين× من الحجاز إلى العراق، (جامعة البصرة، مجلّة الخليج العربي، ع 23، 1431هـ/2010م، ص141). 623. مسلم بن عقيل× دراسة لدوره في ثورة الإمام الحسين×، (جامعة البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، مجلّة الخليج العربي، مج 42، ع 1 ـ 2، 1435هـ/2014م). |
|
* الحوري، أحمد عبيد عيسى. 624. الجانب الاجتماعي في خلافة عمر بن عبد العزيز من خلال كتاب ابن الجوزي (سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز)، (ع 38، مج 10، 2014 م، ص 63 ـ 85). |
|
* الخفاجي، إيمان سالم حمودي. 625. علي بن موسى الرضا× وولاية العهد، (جامعة القادسيّة، مجلّة القادسيّة للعلوم الإنسانية، ع4، مج 15، 2012، ص 217 ـ 241). |
|
* سعيد، حيدر لفتة. 626. واقعة الحرّة دراسة تاريخية، (مجلّة دراسات الكوفة، ع13، مج1، 1430هـ/2009م). |
|
* الشهرستاني، هبة الدين. 627. زينب في عاصمة أبيها، (النجف الأشرف، مجلّة الغري، ع 9 و10، 1366هـ/1947م، ص3). |
|
* صالح، سمير وعبّاس عاجل. 628. الحروب الصليبية تطور المصطلح والمفهوم، (جامعة بابل، مجلّة جامعة بابل للعلوم الصرفة، مج 19، ع 4، 1432هـ/2011م). |
|
* الطائي، عبد الستّار إسماعيل عبد الرحمن. 629. الممارسات الشورية في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، (جامعة الموصل، مجلّة التربية والعلم، ع4، مج17، 2010 م، ص 1 ـ 13). |
|
* عبد العالي، مظفّر. 630. الفتح والاستشهاد في ذكرى الحسين، (النجف الأشرف، مجلّة الأضواء، ع3، 6، 1385هـ/1966م، ص219). |
|
* عبد المجيد، عبد الملك. 631. سياسة الحسن بن عليE في وحدة المسلمين، (جامعة تكريت، مجلّة جامعة تكريت للعلوم الإسلامية، ع12، 1433هـ/2012م، ص262ـ 290). |
|
* عبد علي، محمّد. 632. معجزة الإسراء والمعراج دراسة شرعية، (جامعة الهيئة العلمية الاستشارية، مجلّة البحوث والدراسات الإسلامية، ع38، 2014/ 1435م، الصفحات437 ـ 492). |
|
* علي، عبد صالح محمّد. 633. البريد في العصور الإسلامية، (جامعة الأنبار، مجلّة العلوم الإنسانية، مج 4، 1423هـ/2003م، ص7، وما بعدها). |
|
* فتحي، طارق، وفاء أحمد. 634. مدينة مرو في المصادر الجغرافية العربية، (جامعة الموصل، مجلّة التربية والعلوم، مج 16، ع 38، 1430هـ/2009م). |
|
* كسّار، علي. 635. الجذور التاريخية لظاهرة الرقيق عند الشعوب القديمة وعرب الجزيرة قبل الإسلام، (جامعة كربلاء، مجلّة كلية التربية، ع 5، 1434هـ/2013م). |
|
* الكعبي، هاشم ناصر حسين، علي عبد الستار فاضل حمود الصيوان. 636. حبيب بن مظاهر الأسدي ودوره في معركة الطفّ، (مجلّة جامعة كربلاء العلمية، ع1، مج12، 1435هـ/2014م). |
|
* اللهيبي، حسين عبد العال. 637. دور الإمام علي بن موسى الرضا× في الحراك الفكري والسياسي، (جامعة القادسيّة، مجلّة القادسيّة للعلوم الإنسانية، ع4، مج14، 1433هـ/2012 م، ص46 ـ 45). |
|
* المحمّدي، عصام خليل إبراهيم وعمر حميد مراد. 638. مواقف العلماء من رواية الحسن البصري عن الإمام علي بن أبي طالب×، (الجامعة المستنصرية، مجلّة كليّة التربية، ع73، مج 18، 2012م، ص175 ـ 206). |
|
* ملحم، حسين طاهر. 639. الفكر السياسي عن أهل البيت صلح الحسن أنموذجاً، (جامعة الكوفة، مجلّة الآداب، ع13، مج 1، 1433هـ/2012م، ص379 ـ 406). |
|
* ناصر، شكري. 640. معركة الجمل دراسة في تحديد الموقع، (مجلة دراسات البصرة، ع 13، 1433هـ/2012م، ص 91 ـ 120). |
|
* نصر الله، جواد كاظم. 641. الإسراء والمعراج دراسة في ردّ الشبهات هيئة كتاب التاريخ برئاسة معاوية، (مجلة رسالة الرافدين، ع5، 1428هـ/2008م، ص 89 ـ 117). |
3. Guinness، Guinness world records، 2015.
4. Seymour drescher، A History of Slavery and Antislavery، Cambridge، 1430، 2009.
5. T. Muhammed yolcu، sözlük، sözlük، Dar bayrağı Beyrut، Lğbnan، 1413، 1993.
|
المحتويات
[1] البقرة: آية31.
[2] الفيض الكاشاني، محمّد، المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء: ج1، ص 111.
[[3]][3] المجادلة: آية11.
[4] البقرة: آية129.
[5] آل عمران: آية164.
[6] الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
[7] البقرة: آية253.
[8] الصدوق، كمال الدين وإتمام النعمة: ص206؛ هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن: ج4، ص195؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج36، ص254.
[9] لقد استعملنا لفظة الطفّ هنا؛ لكونها من بين الالفاظ الأكثر رواجاً في تلك الحقبة الزمنية، والتي كانت تُطلق على الموضع الذي قُتِل فيه الإمام الحسين×. يُنظر: الحكيم، حسن عيسى، خطط كربلاء في فكر الإمام الصادق×: ص7ـ8.
[10] لقد استعملنا طبعتين من مصنف أبي مخنف، تختلفان في ما ورد فيهما من روايات وكانت قد حققت احداهما دون الاخرى، الاولى: مقتل الحسين×، تحقيق: حسين الغفاري، قم، المطبعة العلمية، د. ت، والثانية: مقتل الحسين×ومصرع أهل بيته واصحابه في كربلاء المشتهر بمقتل أبي مخنف، ط1، د. م، نشر دار الزهراء، 1428هـ/2007م، وقد ورد فيها ذكر لأحداث مواضع الطريق بين الكوفة وبلاد الشام الذي سلكته قافلة السبايا.
[11] المفيد، محمّد بن محمد، تصحيح اعتقادات الإمامية: ص155؛ ياقوت، معجم الأدباء: ج6، ص3.
[12] ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج3، ص37؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج2، ص487؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص119؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص110؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص25؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج2، ص55؛ القلقشندي، مآثر الانافة في معالم الخلافة: ج1، ص105؛ محمّد الريشهري، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة: ج7، ص298.
[13] الطبري، تاريخ الرسل والملوك: ج4، ص126؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص15؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص273؛ المتّقي الهندي، كنز العمال: ج11، ص349.
[14] خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص153؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص122؛ الطبري، تاريخ الرسل والملوك: ج4، ص126؛ المسعودي، التنبيه والإشراف: ص260؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج4، ص387.
[15] الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج1، ص222؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3 ص1418؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج28، ص35؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج4، ص387؛ الزركلي، الأعلام: ج2، ص200؛ محمّد الخضري بك، محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية الدولة الأموية: ج2، ص424. وعام الجماعة سُمّي بهذا الاسم لاجتماع أمر المسلمين تحت حكم معاوية. ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج5، ص109؛ الشيخ المفيد، الافصاح: ص104؛ ابن طاووس، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص205.
[16] الجاحظ، رسائل الجاحظ(رسالة في النابتة): ج2، ص11.
[17] معاوية بن أبي سفيان: ص37.
[18] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص184؛ راضي آل ياسين، صلح الحسن: ص259؛ حسين طاهر محلم، الفكر السياسي عن أهل البيت، صلح الحسن انموذجاً: ص399ـ398؛ عبد الملك عبد المجيد، سياسة الحسن بن علي في وحدة المسلمين: ص276ـ285.
[19] ابن أعثم، الفتوح: ج4، ص219؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج13 ص264؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج2، ص193؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص65؛ سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج2، ص425؛ محمّد سليم عرفة، إفادات من ملفات التاريخ: ص212.
[20] القلقشندي، مآثر الانافة في معالم الخلافة: ج1، ص108؛ محمّد حسين الحاج، حقوق آل البيت في الكتاب والسنّة باتّفاق الأئمّة: ص127؛ علي الكوراني، الإنتصار: ج8، ص126.
[21] هي المعركة التي وقعت في البصرة سنة 36هـ/656م، بين جيش الإمام علي بن أبي طالب× والجيش الذي يقوده طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، بالإضافة إلى عائشة التي خرجت معهم في هودج على ظهر جمل، وسُمِّيت المعركة نسبة إلى ذلك الجمل. الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3 ص519ـ547؛ الشيخ المفيد، الجمل: ص120ـ213؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3 ص205ـ260؛ هادي عبد الكريم، معركة الجمل الأسباب والنتائج دراسة تاريخية: ص6ـ86؛ شكري ناصر، معركة الجمل دراسة في تحديد الموقع: ص93ـ108.
[22] وهي المعركة التي وقعت بين الإمام علي بن أبي طالب× وجيش معاوية بن أبي سفيان في شهر صفر 37هـ/657م بعد موقعة الجمل بسنة. للمزيد من المعلومات عن واقعة صفين يُنظر: المنقري، وقعة صفّين: ص134ـ483؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص2ـ46؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3 ص276ـ289؛ حارس رميلي عبد الكاظم، كتاب وقعة صفّين للمنقري دراسة تحليلية: ص136ـ386.
[23] ابن أعثم، الفتوح: ج3، ص290؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص571؛ راضي آل ياسين، صلح الحسن: ص260. ودار ابجرد، مدينة في كورة اصطخر في اقليم فارس، وفيها معدن الزئبق، وتبعد عن شيراز 150 ميلاً أي ما يعادل 241 كم، وهي عامرة آهلة، وفيها تجار وأسواق وبيع وشراء، وعليها سور حصين، ويدور حوله خندق تجتمع فيه فضول المياه التي تسقى بها النخيل، وفيها عيون كثيرة، ولها أربعة أبواب، وفي وسطها جبل عال كالقبّة. يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص419؛ الحميري، الروض المعطار في خبر الاقطار: ص234.
[24] الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص43؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة في معرفة الأئمّة: ج2، ص734؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص65؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج11، ص6؛ جعفر السبحاني، الأئمّة الاثني عشر: ص61.
[25] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص14؛ الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص403؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج2، ص138؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص570؛ جعفر السبحاني، أضواء على عقائد الشيعة الإمامية: ص35؛ علي الكوراني، جواهر التاريخ: ج2، ص247.
[26] أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص77.
[27] هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي، يُكنّى أبا عبد الله، ويُقال: أبو عيسى، أسلم في سنة 5هـ/626م، وشهد معركة اليرموك وذهبت عينه فيها، وولي البصرة نحو سنتين، وولّاه عمر بن الخطاب على الكوفة، وأقرّه عليها عثمان بن عفّان ثمّ عزله، وولّاه معاوية عليها إلى أن مات فيها سنة 50هـ/670م بمرض الطاعون وعمره سبعون سنة. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج4، ص284؛ الطبراني، المعجم الكبير: ج20، ص366؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص388؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج60، ص13؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج3، ص453.
[28] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4 ص126.
[29] الهلالي، سليم بن قيس: ص18؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج3، ص390؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج33، ص108؛ يوسف البحراني، الدرر النجفية: ج3، ص402؛ حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ج7، ص143؛ سعيد أيوب، معالم الفتن: ص196؛ محمّد تقي الخراساني، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: ج6، ص399.
[30] هي من الزندقة، وهي كلمة فارسية معرّبة، والزنادقة تؤمن ببقاء الدهر وعدم وحدانية الخالق، والزنديق: هو مَن أظهر الإسلام وأبطن الكفر. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج5، ص255؛ ابن ادريس الحلّي، أجوبة مسائل ورسائل: ص283؛ ابن منظور، لسان العرب: ج10، ص147.
[31] ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج11، ص44.
[32] هو زياد ابن ابيه، ويقال زياد بن سمية، ويقال له زياد بن عبيد الثقفي، قبل أن يستلحقه معاوية ابن أبي سفيان بنسبه، واختُلِف في سنة ولادته، قيل: ولد عام الهجرة، وقيل: يوم بدر، ويُكنّى أبا المغيرة، وليست له صحبة ولا رواية، كان كاتباً في البصرة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (13ـ23هـ/634ـ643م)، ثمّ ولّاه الإمام علي بن أبي طالب× اقليم فارس، واستلحقه معاوية، وولّاه العراقين الكوفة والبصرة، وتُوفّي في الكوفة سنة 53هـ/672م. يُنظر: إبراهيم الثقفي، الغارات: ج2، ص925؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج1، ص567؛ ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة: ج4، ص399.
[33] الهلالي، سليم بن قيس: ص316ـ318؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج33، ص179؛ علي خان الشيرازي، رياض السالكين لشرح صحيفة سيد الساجدين: ج1، ص177؛ يوسف البحراني، الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية: ج3، ص400؛ حبيب الله الخوئي، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: ص242؛ جعفر مرتضى العاملي، الصحيح من سيرة النبي الاعظم: ج4، ص262؛ محمّد تقي الخراساني، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: ج6، ص399.
[34] هو حجر بن عدي بن معاوية بن جبلة بن ربيعة بن معاوية الكندي، أسلم في مقتبل شبابه حين قدومه مع أخيه هاني على النبي| في المدينة، شهِد القادسيّة، وكان حجر من أنصار الإمام علي ابن أبي طالب×، وقد أسرع إلى مبايعته عند تولّيه الخلافة، وظلّ ملازماً له، وحارب معه في صفين. عن سيرة حجر ومقتله. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج5، ص253؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص141؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص188؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج17، ص90؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص56؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج3، ص12؛ أحمد البراقي، تاريخ الكوفة: ص319؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج4، ص582؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج9، ص119؛ هاشم محمّد، شهيد الولاء حجر بن عدي الكندي، ص10ـ157.
[35] هي قرية بغوطة دمشق، وهي أول قرية في الجبل، وفيها منارة، وتقع على بعد 12 ميلاً عن دمشق. يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص91؛ الحميري، الروض المعطار: ص536.
[36] هو عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن ذراح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي، أسلم قبل الفتح، وكان من أصحاب الرسول’، وهاجر إلى المدينة، ثمّ أصبح من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب×، سكن الكوفة، شهِد معه الجمل وصفين والنهروان، وأخبره الإمام علي× بأنّه " مقتول، ورأسك منقول " وقد قُتل في الموصل، ونُقل رأسه إلى الشام ليوضع أمام معاوية، ومن ثمّ يوضع في حضن زوجة عمرو بن الحمق التي كانت قد أودعت السجن. ابن قتيبة، المعارف: ص66؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص524؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج2، ص290؛ جعفر النقدي، الأنوار العلوية: ص467؛ عبدالله حسن آل درويش، المجالس العاشورية في المآتم الحسينية: ص597؛ محمّد بيومي مهران، الإمامة وأهل البيت: ج1، ص237.
[37] لمعرفة تفاصيل أوسع عن قتل أصحاب حجر بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي؛ يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج19، ص203؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص462؛ محمّد علي الاردبيلي، جامع الرواة: ج1، ص319؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج31، ص297 و ج34، ص301؛ حسين النوري الطبرسي، خاتمة المستدرك: ج7، ص306؛ حسن القبانچي، مسند الإمام علي: ج1، ص151؛ علي النمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث: ج2، ص248؛ محمّد تقي الخراساني، مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة: ج6، ص515.
[38] الحضرميين أو الحضارمة، هو لفظ يُطلق على القبائل اليمنية، والتي تسكن حضرموت. ابن سعد، الطبقات: ج4، ص359.
[39] البلاذري، أنساب الأشراف: ج5، ص129؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص19.
[40] ابن قتيبة، فضل العرب والتنبيه على علومها: ص37.
[41] محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص38؛ علي رحيم أبو الهيل، السياسة الأموية المضادة للإمام علي: ص107.
[42] الدولة الأموية: ج2، ص20.
[43] الاحنف بن قيس، الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وأمّه من بني قراض من باهلة، ولدته وهو أحنف، فقالت وهي ترقصه:
|
والله لولا حنـف في رجله |
ويُكنّى الأحنف أبا بحر، وكان ثقة مأمونا، قليل الحديث، وقد روى عن عمر بن الخطاب والإمام علي بن أبي طالب× وأبي ذر، تُوفي سنة 67هـ/686م. ابن سعد، الطبقات: ج7، ص93؛ ابن معين، تاريخ ابن معين: ج2، ص138؛ البخاري، التاريخ الصغير: ج1، ص184؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص360.
[44] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص138.
[45] هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس القرشي الأموي، يكنّى أبا عبد الملك، ولد بمكّة عام 2هـ/623م، وأسلم عام الفتح 8هـ/629م، كان منفياً مع أبيه من قِبَل النبي إلى الطائف، وردّه عثمان بن عفّان، وكان كاتباً له، وولّي المدينة في عهد معاوية، وظلّ يتعاقبها مع سعيد بن العاص، نظر إليه علي بن أبي طالب فقال: ويلك وويل أمّة محمّد منك ومن بنيك، ولّي الخلافة بعد معاوية بن يزيد، وتُوفّي عام 65هـ/684م؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص427ـ428؛ ابن بكار، الأخبار الموفقيات: ص258.
[46] هي جعدة بنت الاشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، وأمّها أمّ فروة أخت أبي بكر، وهي أخت محمّد بن الاشعث، ولها أسماء عدّة وأشهرها: جعدة، وقد تزوّجها الإمام الحسن بن علي÷ أيّام خلافة أبيه على الكوفة، واستمرت حياتها مع زوجها حوالي احدى عشرة سنة، ولم تنجب للإمام الحسن× من الاولاد أحداً، وقد تزوّجت بعد استشهاد الإمام الحسن× من يعقوب بن طلحة بن عبيد الله، ولم تتزوّج من يزيد. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص14؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص32؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج1، ص389؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج9، ص138.
[47] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص16؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج1، ص151؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص273؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص167؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج13، ص303؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص155.
[48] ابن أعثم، الفتوح: ج4، ص332؛ علي الكوراني، جواهر التاريخ: ج3، ص3.
[49] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص184؛ ابن أعثم، الفتوح: ج4، ص219، 332؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج13، ص264؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص65؛ سليمان ابن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج2، ص425؛ محمّد سليم عرفة، إفادات من ملفات التاريخ: ص212.
[50] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص152؛ أحمد راسم النفيس، على خطى الحسين: ص64؛ لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين: ص291.
[51] جعفر البياتي، الأخلاق الحسينية: ص155؛ أحمد راسم النفيس، على خطى الحسين: ص46.
[52] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص153؛ علي الكوراني، جواهر التاريخ: ج3، ص383؛ جعفر البياتي، الأخلاق الحسينية: ص195.
[53] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص152؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج2، ص223؛ محمّد مهدي شمس الدين، ثورة الحسين× ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية: ص155.
[54] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص202؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص153؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص224؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص212؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص282؛ أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث: ج19، ص212.
[55] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص146ـ147؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج5، ص129ـ130، الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص19؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص212؛ علي خان الشيرازي، الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: ص435؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص582؛ أبو القاسم الخوئي معجم رجال الحديث: ج19، ص212؛ وحيد الخراساني، منهاج الطالبين: ج1، ص354؛ انطون بارا الحسين في الفكر المسيحي ص209.
[56] الهلالي، سليم بن قيس: ص320؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج33، ص182.
[57] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص149؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج40، ص298؛ نور الله المرعشي، شرح إحقاق الحقّ: ج26، ص563؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج10، ص228؛ محمّد الريشهري، موسوعة الإمام علي بن أبي طالب في الكتاب والسنة والتاريخ: ج11، ص314.
[58] ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص503؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص348؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج2، ص190، 191؛ أحمد شلبي، التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية: ج2، ص41.
[59] ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص504؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص348، 349؛ مرتضى العسكري، أحاديث أمّ المؤمنين عائشة: ج1، ص331؛ محمّد بن عقيل العلوي، النصائح الكافية: ص64؛ مركز الأبحاث العقائدية، موسوعة حياة المستبصرين: ج3، ص297.
[60] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص153؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص225؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص505؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص350؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج10، ص230.
[61] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج40، ص298؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص348؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج10، ص229؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج2، ص191.
[62] هو عبد الله بن عباس بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي الهاشمي، وُلِد قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: وُلِد في الشُعب قبل خروج بني هاشم منه، وكانت له صحبه ورواية، وكانوا يسمونه البحر والحبر لعلمه، برع في العلم والفقه والتفسير، وكان عمر بن الخطاب يحبه ويدنيه ويقرّبه ويشاوره، وكان يقول: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، توفي في الطائف سنة 68هـ/678م، وكان عمره 78 سنة. يُنظر: ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص351ـ352؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج3، ص291.
[63] هو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطّلب الهاشمي القرشي، أمّه أسماء بنت عميس الخثعمية، وُلِد في أرض الحبشة لمّا هاجر أبوه إليها، وهو أوّل مولود من المسلمين في الحبشة، وحفظ عن النبي وروى عنه، وكان كريماً جواداً يُقال له قطب السخاء، كان أحد أمراء عمّه الإمام علي× يوم صفين، توفي سنة 80هـ/699م. يُنظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص289.
[64] هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، وهو شقيق حفصة، وأمهما زينب بنت مضعون، ويكنّى بأبي عبد الرحمن، وهو صحابي وله رواية، و صحب أباه في هجرته إلى المدينة قبل أن يحتلم، وشهد الخندق سنة 5هـ/626م وما بعدها، وشهد فتح مصر، وتُوفّي في مكّة سنة 74هـ/693م. ابن سعد، الطبقات: ج2، ص373، و ج4، ص142؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص341؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج1، ص171؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص347.
[65] هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي، يكنّى أبا بكر، أمّه أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، وُلِد سنة 2هـ/623م في المدينة، وهو أوّل مولود للمهاجرين وُلِد في المدينة، شهد وقعة الجمل مع أبيه وخالته عائشة، وبويع بالخلافة سنة 64هـ/683م، وكان معادياً للأمويين، واجتمعت له الحجاز واليمن والعراق وخراسان، قتله الحجّاج بن يوسف الثقفي(75ـ95هـ/694ـ713م) في سنة 73هـ/692م في مكّة. يُنظر: ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص301ـ302؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص309ـ310؛ قصي أسعد عبد الحميد الراوي، آل الزبير ودورهم في الدولة العربية الإسلامية حتى منتصف القرن الثالث الهجري، ص34ـ48.
[66] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص196؛ نور الله المرعشي، شرح إحقاق الحقّ: ج26، ص563؛ محمّد مهدي الخراساني، موسوعة عبد الله بن عبّاس: ج5، ص98.
[67] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص197؛ المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج3، ص343؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج10، ص236.
[68] ابن أعثم، الفتوح: ج4، ص335؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص506؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج10، ص236؛ مرتضى العسكري، أحاديث أمّ المؤمنين عائشة: ج1، ص343.
[69] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص153؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج10 ص239.
[70] هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أميّة القرشي الأموي، وُلِد سنة 1هـ/622م، وكان من أشراف قريش وفصحائها، ندبه عثمان بن عفّان في مَن ندبهم لكتابة المصاحف، وقُتِل أبوه في بدر كافراً، وشاركَ المسلمين في حربهم في طبرستان، وولّاه عثمان بن عفّان الكوفة، وتخلّف عن معاوية في حروبه، وكان معاوية عاتباً عليه في ذلك، ثمّ ولّاه المدينة، وكان يتعاقبها مع مروان بن الحكم، وتُوفّي سنة 53هـ/672م. يُنظر: ابن بكار، الأخبار الموفقيات: ص258؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص621؛ ابن خلدون، العبر: ج2، ص134؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص47؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج31، ص160.
[71] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص153؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج10، ص239؛ علي الكوراني، الإنتصار: ج8، ص362.
[72] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص153؛ محمّد بن عقيل، النصائح الكافية: ص65؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير ج10، ص239.
[73] هو عبيد
الله بن العباس بن عبد المطّلب الهاشمي القرشي، يكنّى أبا محمد، أصغر من أخيه
عبد الله بسنة، وأمهما واحدة، وهو ابن عم النبي’، وله صحبه ورواية، ولّاه الإمام
علي بن أبي طالب× في خلافته (35ـ40هـ/656ـ661م) اليمن، وقتل بسر بن أبي أرطاة قائد
جيش معاوية، له ابنان، وتُوفّي في المدينة سنة 58هـ/678م. يُنظر: ابن عبد البر،
الاستيعاب: ج2، ص429؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج4، ص267؛ ابن حجر العسقلاني،
الإصابة: ج2، ص437.
[74] ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج1، ص295.
[75] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص154؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص355.
[76] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص155. وفدك: هي قرية من قرى خيبر، وأرضها خصبة ذات أودية ومياه وعيون ومزارع ونخل كثير، وهي من أعمال المدينة، بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر أقل من مرحلة، وبعد معركة خيبر جلا عنها أهلها، فصارت ملكاً خالصاً للنبي|، التي أنحلها إلى ابنته فاطمة‘قبل موته بأربع سنين، وقيل أنّ خراجها سنويّاً ثلاثمائة ألف دينار. تفاصيل أوسع عن فدك يُنظر: سامي جودة بعيد الزيدي، فدك حتى نهاية العصر العباسي: ص13ـ52.
[77] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص173؛ ابن حبّان، الثقات: ج3، ص373؛ مشاهير علماء الأمصار: ص85.
[78] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص239؛ القلقشندي، مآثر الانافة في معالم الخلافة: ج1، ص115؛ نور الله المرعشي، شرح إحقاق الحقّ: ج33، ص653؛ صالح مهدي، الحسين قائد الإنتصار بالمظلومية: ص56.
[79] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص225؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص505؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص350؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج10، ص230؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج2، ص181.
[80] هو الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان، ولّاه عمه معاوية ابن أبي سفيان المدينة سنة 59هـ/678م، ولما جاء نعي معاوية وبيعة يزيد. لم يشد على الحسين× وابن الزبير حتى لامه مروان بن الحكم على ذلك، فرد عليه قائلا: ما كنت لأقتلهما ولا اقطع رحمهما، وقد أرادوه للحكم بعد معاوية بن يزيد فرفض وتُوفّي بعده بمدّة قصيرة. يُنظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص170؛ الدينوري، الأخبار الطوال ص227؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص631.
[81] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص241؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج2، ص247؛ مرتضى العاملي، عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني: ص86.
[82] يُنظر: ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص13؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج5، ص302؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص15؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص157؛ البري، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله: ص41؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: ج3، ص20؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص14، 15؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص18؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص326؛ مرتضى العسكري، معالم المدرستين: ج3، ص47؛ محسن الأمين، لواعج الاشجان: ص25؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج2، ص205، 254، 255؛ لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين: ص343؛ مركز الأبحاث العقائدي، موسوعة من حياة المستبصرين: ج1، ص40ـ47.
[83] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص18؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص269.
[84] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص6؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص252؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص378؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17. وبألفاظ أخرى يُنظر: ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص18؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص269.
[85] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص155؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص254؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص171؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج2، ص256.
[86] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص21؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص273.
[87] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص371.
[88] القصص: آية22.
[89] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص261.
[90] هو سليمان بن صرد بن جون الخزاعي صحابي خيّر فاضل له دين وعبادة، سكن الكوفة، وله قدر وشرف في قومه، وكان من اصحاب الإمام علي بن أبي طالب×، وشهد معه كلّ معاركه، وكان من الذين كتبوا للإمام الحسين×، بعد موت معاوية، يسأله القدوم إلى الكوفة، إلّا أنه لم يتمكّن من القتال معه، وندم على ذلك، فقاد حركة التوابين سنة 65هـ/684م الذين قاتلوا عبيد الله في عين الوردة، وقتل سليمان فيها وحمل رأسه إلى مروان بن الحكم(64ـ65هـ/ 683ـ684م) في الشام ويومها هو الحاكم الأموي. يُنظر: ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص63ـ64؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج2، ص351.
[91] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص15؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص229؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص282.
[92] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص15ـ17؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص229؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص258؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص27ـ29؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص282ـ283؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص385.
[93] هو قيس بن مسهر بن خالد بن جندب بن منقذ بن عمرو حتى يصل إلى أسد بن خزيمة، الاسدي الصيداوي، وصيدا بطن من اسد، وهو رجل شريف في بني صيدا، نشأ مخلصاً في محبته لأهل البيت، وكان قد حمل كتب أهل الكوفة إلى الإمام الحسين× في المدينة، وقد قبض عليه وهو يحمل رسالة من الإمام الحسين× إلى أهل الكوفة، من قبل الحصين بن نمير، وتم قتله في اواخر سنة 60هـ/679م. يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص297؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص181؛ محمّد السماوي، إبصار العين في أنصار الحسين: ص112.
[94] يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص262؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص37؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص172.
[95] يزيد بن نبيط، ويُسمّى أيضاً بدر بن رقيط، قدم إلى الإمام الحسين مع ولديه عبد الله وعبيد الله لنصرته من البصرة إلى مكّة، وقد استشهدوا جميعاً في معركة الطف. الطوسي، الأبواب (رجال الطوسي): ص106؛ ابن طاووس، إقبال الأعمال: ج3، ص345؛ علي النمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث: ج2، ص8.
[96] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص16ـ18؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص370؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص229؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص28ـ29؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص386.
[97] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص17؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص30ـ31؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص284؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص385ـ386.
[98] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص266؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص158.
[99] سليمان بن رزين مولى الحسين بن علي بن أبي طالب، كان سليمان هذا من موالي الحسين×، أرسله بكتب إلى رؤساء الأخماس بالبصرة حين كان بمكّة. أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص24؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص231؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص265؛ ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل: ج3، ص507؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص25.
[100] وهو عبيد الله ابن زياد ابن ابيه 53هـ/672م، وكنيته أبو حفص، وتولّى ابن زياد خراسان من قِبل معاوية بن أبي سفيان سنة (54هـ/673م)، وفي سنة (55هـ/674م) تولّى البصرة، وولّاه يزيد بن معاوية سنة (60هـ/679م) الكوفة، ورجع إلى البصرة سنة 61هـ/680م بعد قتل الإمام الحسين بن علي÷، واختلف أهل البصرة عليه بعد موت يزيد، وكاد أن يُقتل إلّا أنّه التحق بالشام سنة 64هـ/683م، ثمّ بايع مروان بن الحكم (64ـ65هـ/683ـ684م)، وحارب التوابين، وهزمهم سنة 65هـ/684م، وحارب المختار بن أبي عبيد الثقفي سنة 66هـ/685م، وقتله إبراهيم بن مالك الاشتر سنة 67هـ/686م. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج4، ص42 و ج5، ص25؛ خليفة ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص166؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص219؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص544.
[101] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص26؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص359؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص37؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص388؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص28.
[102] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج2، ص182؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص370؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص169؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج4، ص377؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص308. مسلم بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، كنيته أبو داود، وكان أشبه ولد عبد المطّلب بالنبي’، أدرك جماعة من أصحاب النبي’، وكان رسول الحسين إلى أهل الكوفة، إلّا أنّه وقع بيد بن زياد، فقتله في سنة 60هـ/679م. تفاصيل أوسع عن سيرة مسلم بن عقيل، يُنظر: علي إبراهيم عبيد الجميلي، مسلم بن عقيل دراسة تاريخية؛ محسن مشكل فهد، مسلم بن عقيل× دراسة لدوره في ثورة الإمام الحسين×: ص338ـ356.
[103] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص17؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص230؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص262؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص386.
[104] عن سيرة المختار ودوره السياسي يُنظر: رغداء حسين محمد، حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي وأبعادها السياسية والفكرية: ص5ـ105.
[105] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص41؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص275؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم: ج2، ص48؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص173؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص30؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص25.
[106] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص275؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ص302؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص30.
[107] هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري من بني كعب بن الحارث بن الخزرج، وأمّه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وُلِد قبل وفاة النبي’ بثمان سنين، وقيل بست سنين ولي إمرة الكوفة، ثمّ قتل بحمص سنة 65هـ/684 م وله أربع وستون سنة. وللمزيد يُنظر: ابن حبان، الثقات: ج3، ص409؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص411؛ ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج2، ص248.
[108] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص258.
[109] المصدر السابق؛ المزي، تهذيب الكمال: ج6، ص424؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب: ج2، ص302.
[110] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص22؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص231؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص35ـ36؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص387؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص388.
[111] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص23؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص231؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص258؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص36؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص288.
[112] البلاذري، أنساب الأشراف: ج2، ص78؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص266؛ الطبرسي، أعلام الورى: ج1، ص437؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص164.
[113] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص26ـ27؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص232؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص267؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص39.
[114] الدينوري، الأخبار الطوال: ص239؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص50؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص298.
[115] هو هاني بن عروة بن نمران بن عمرو بن قعاس بن عبد يغوث ابن مخدش بن حصر بن غنم بن مالك بن عوف بن منبه بن غطيف بن مراد بن مذحج، أبو يحيى المذحجي المرادي الغطيفي، كان هاني صحابيا كأبيه عروة، وكان معمّرا، حضر مع الإمام علي× حروبه الثلاث، وهو القائل يوم الجمل:
|
يا لك حربا حثها جمالها |
قتله عبيد الله بن زياد هو ومسلم بن عقيل، وجرّهما في الأسواق. يُنظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص176؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ص406؛ محمّد السماوي، إبصار العين في أنصار الحسين: ص139.
[116] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص59؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4؛ ص285؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص62.
[117] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص371.
[118] هو محمّد بن الاشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي، وأمّه أمّ فروة بنت أبي قحافة، أخت أبي بكر، وأخته جعدة زوجة الإمام الحسن بن علي×، وعاش في أيّام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفّان والإمام علي بن أبي طالب×، وكان مع الإمام علي في صفّين، ثمّ خرج مع الخوارج، وكان مع جيش ابن سعد الذي قتل الإمام الحسين×، وقُتل في أيّام المختار بن أبي عبيد الثقفي، ويروى عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق÷ قوله: إنّ الاشعث بن قيس شارك في دم أمير المؤمنين×، وابنته جعدة سَمَّت الحسن×، وابنه محمّد شارك في دم الحسين×. ابن أعثم، الفتوح: ج1، ص68؛ الكليني، الكافي: ج8، ص167؛ الفيض الكاشاني، الوافي: ج2، ص239.
[119] أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص107ـ 108؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ص312ـ314.
[120] هو الحصين بن نمير بن نائل أبو عبد الرحمن الكندي، ثمّ السكوني من أهل حمص، وهو الذي حاصر عبد الله بن الزبير بمكة ورمى الكعبة بالمنجنيق، وكان في آخر أمره على ميمنة عبيد الله بن زياد في حربه مع إبراهيم بن الأشتر، فقُتل مع ابن زياد على مقربة من الموصل. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص285؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج6، ص2818؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج13، ص56ـ66؛ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج8، ص245؛ الزركلي، الأعلام: ج2، ص262.
[121] القادسيّة، وقد سُمِّيت بقادس هراة، وكانت تُسمّى قدّيسا، وبهذا الموضع كانت معركة القادسيّة، بين المسلمين والفرس، سنة 16هـ/637م في عهد عمر بن الخطاب، وتبعد القادسيّة عن الكوفة خمسة عشر فرسخاً، أي 72 كم، وهي تقع على طريق الحاجّ من الكوفة إلى مكّة على حافّة البادية. ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص175؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص161؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص192؛ أبو الفداء، تقويم البلدان: ص299؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1054.
[122] هو موضع قرب الكوفة، يسلكه الحاجّ أحياناً، وقيل فوق القادسيّة. يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص379.
[123] القطقطانة، بالضمّ ثمّ السكون، ثمّ قاف أخرى مضمومة، وطاء أخرى، وبعد الألف نون وهاء، موضع قرب الكوفة من جهة البرية، وكان فيه سجن النعمان بن المنذر، أحد ملوك دولة المناذرة. أبو عبيد البكري، معجم ما أستعجم: ج3، ص1083؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص374؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1107؛ ابن رستم الطبري، نوادر المعجزات: ص107.
[124] هو جبل من آخر السواد إلى البرّ ما بين البصرة والكوفة، وهي من منازل بني تميم. يُنظر: أبو عبيدة البكري، معجم ما استعجم: ج4، ص156.
[125] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص297؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص402.
[126] هي منزل بطريق مكّة، بعد القرعاء نحو مكّة، وقبل العقبة دون زبالة بمرحلتين، ويُقال لها: واقصة الحزون؛ لأنّه أُحيط بها من كلّ جانب، وهي ماء لبني كليب. يُنظر: أبو عبيدة البكري، معجم ما استعجم: ج4، ص1365؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص354؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1421.
[127] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص295.
[128] المصدر السابق: ص306؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ص320ـ321.
[129] عبد الله بن يقطر هو أخو الحسين بن علي÷ من الرضاعة، أُرسِل إلى مسلم× قبل أن يُعلم بمقتله، فتلقّاه الحصين في القادسيّة، وبعثه إلى ابن زياد وتمّ قتله. يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص244؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص300؛ ابن حبّان، الثقات: ج2، ص310؛ الشيخ المفيد، الاختصاص: ص83؛ ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص340؛ ابن طاووس، إقبال الأعمال: ج3، ص346.
[130] يُقال عنه أنّه فارسي، مولى بني معاوية من الأنصار ومن الأوس، وفي رواية أنّه من أصحاب الرسول’ وشهِد معه معركة أُحد، وكنّاه النبي(|) أبا عبد الله، وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب× أيضاً. يُنظر: ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج2، ص176؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج1، ص516.
[131] الطوسي، الأمالي: ص165.
[132] ميثم التّمار: صحابي سكن الكوفة وله فيها ذرية، وكان عبداً لامرأة من بني أسد فاشتراه الإمام علي× منها وأعتقه، وحبسه ابن زياد مع المختار، ثمّ أمر بقتله. يُنظر: إبراهيم بن محمّد الثقفي، الغارات: ج2، ص796؛ الطوسي، الخلاف: ج1، ص30؛ الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1 ص341؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج2، ص291؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج6، ص249ـ250؛ التفرشي، نقد الرجال: ج4، ص445.
[133] الشيخ المفيد، الإرشاد: ص246ـ248.
[134] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص253؛ الخوارزمي، مقتل الحسين× ج1، ص318.
[135] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص67.
[136] ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص401.
[137] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص67؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص289؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص67؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص400.
[138] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص65؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص374؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص287؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص66؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص400ـ401.
[139] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص311؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص160.
[140] المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص55؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص307.
[141] المسعودي، إثبات الوصية: ص176؛ حسين عبد الوهاب، عيون المعجزات: ص61.
[142] هي هند
بنت أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤي
ابن غالب بن فهر، اشتهرت أمّ سلمة بهذه الكنية نسبة إلى ولدها الأكبر سلمة من
زوجها
عبد الله بن عبد الأسد، وبعد زواجها من الرسول’ كُنيّت بأم المؤمنين، تُوفيت في
عهد يزيد في سنة 61هـ/680م، وتحديداً يوم عاشوراء من السنة نفسها، وقيل بعد
استشهاد الإمام الحسين× بمدّة وجيزة. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج2، ص164؛ أبي
حاتم، الجرح والتعديل: ج9، ص464؛ ابن حبان، الثقات: ج3، ص439؛ ابن مندة، معرفة
الصحابة: ج1، ص956؛ البخاري، الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد: ج2،
ص838؛ ابن أيوب الباجي، التعديل والتجريح: ج3، ص1297؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة:
ج7، ص287؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص467.
[143] المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص332؛ محسن الأمين، لواعج الاشجان: ص31.
[144] ابن طيفور، بلاغات النساء: ص59؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص40؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج4، ص101.
[145] الدينوري، الأخبار الطوال: ص265؛ ابن حبان، الثقات: ج2، ص314؛ حيدر لفته سعيد، واقعة الحرّة دراسة تاريخية: ص49ـ52.
[146] يُنظر: نجم الدين الطبسي، الأيّام المكّية من عمر النهضة الحسينية: ص103ـ113.
[147] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص61؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص371؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص297؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص69؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص256؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ص318.
[148] الدينوري، الأخبار الطوال: ص243؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص159؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص405.
[149] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص289؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص315، ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص164.
[150] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص70؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص165.
[151] يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص73ـ75؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص246ـ247؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص295؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج4، ص377؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص45ـ46؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص402، النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص410.
[152] تفاصيل أوسع عن أسباب ثورة الإمام الحسين× يُنظر: مروان عطية، ثورة الإمام الحسين وأثرها على حركات المعارضة: ص23ـ38؛ أحمد عليوي صاحب، مسير الإمام الحسين×: ص23ـ30؛ محسن مشكل، طريق الإمام الحسين× من الحجاز إلى العراق: ص3ـ10.
[153] الفراهيدي، العين: ج5، ص431؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص445؛ الزبيدي، تاج العروس: ج15، ص654.
[154] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج5، ص193.
[155] الجوهري، الصحاح: ج5، ص1810.
[156] الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص44؛ جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدّسة: ج8، ص9.
[157] ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص445؛ ابن منظور، لسان العرب: ج11، ص586؛ تحسين آل شبيب، مرقد الإمام الحسين×: ص13.
[158] جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدّسة: ج8، ص10.
[159] تحسين آل شبيب، مرقد الإمام الحسين×: ص12.
[160] جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدّسة: ج8، ص10.
[161] تحسين آل شبيب، مرقد الإمام الحسين×: ص12.
[162] يُنظر: اسماعيل ذياب خليل العزاوي، خالد بن الوليد دراسة في شخصيته ودوره في الإسلام: ص93ـ122.
[163] تحسين آل شبيب، مرقد الإمام الحسين×: ص15؛ جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدّسة: ج8، ص11.
[164] فرات بن ابراهيم، تفسير فرات الكوفي: ص171؛ ابن قولويه، كامل الزيارات: ص145.
[165] ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص35.
[166] جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدّسة: ج8، ص18.
[167] ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص339.
[168] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص308.
[169] جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدّسة: ج8، ص31.
[170] تحسين آل شبيب، مرقد الإمام الحسين×: ص24.
[171] المجلسي، بحار الأنوار: ج98، ص108؛ حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل: ج10، ص324؛ حسين البروجردي، جامع أحاديث الشيعة: ج12، ص576.
[172] تحسين آل شبيب، مرقد الإمام الحسين×: ص26.
[173] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص80؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج2، ص239؛ الزرندي، معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول: ص94.
[174] ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص208.
[175] الفراهيدي، العين: ج3، ص289.
[176] لسان العرب: ج4، ص223.
[177] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج7، ص365؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم: ج4، ص299؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج11، ص237؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج7، ص55؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج3، ص365؛ تحسين آل شبيب، مرقد الإمام الحسين×: ص21؛ تفاصيل أوسع عن الحائر الحسيني. يُنظر: أمير جواد كاظم مطر، الحائر الحسيني دراسة تاريخية (61ـ656هـ/ 680ـ1258م): ص61.
[178] أحمد بن حنبل، المسند: ج1، ص85؛ ابن مردويه، مناقب علي بن أبي طالب ما نزل من القرآن في علي: ص209؛ ابن المغازلي، مناقب علي بن أبي طالب×: ص312؛ علي الأحمدي، السجود على الأرض: ص138.
[179] المصادر السابقة.
[180] ابن نما الحلّي، ذوب النضار في شرح الثار: ص23؛ عبد الله البحراني، العوالم الإمام الحسين: ص489؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص205؛ حسين النوري الطبرسي، مستدرك الوسائل ج10، ص258.
[181] الراوندي، الخرائج والجرائح: ج2، ص848؛ ابن نما الحلّي، ذوب النضار في شرح الثار: ص13؛ حسن بن سليمان الحلّي، مختصر بصائر الدرجات: ص37.
[182] جعفر الخليلي، موسوعة العتبات المقدّسة: ج8، ص20، 22، 23، 27؛ تحسين آل شبيب، مرقد الإمام الحسين×: ص27.
[183] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص136؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص400؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص256؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج 4، ص359؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص18؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص423.
[184] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص160؛ خليفة ابن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص145؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص406ـ407؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص256ـ257؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص359؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص110.
[185] هو سنان بن أنس ابن عمرو بن حيّ بن الحارث بن غالب بن مالك بن وهبيل(بطن من النخع) بن سعد ان النخع بن سعد بن عمرو بن علة بن جلد، وقد أفلت سنان من قبضة المختار الثقفي في الكوفة عندما كان يتتبّع قتلة الإمام الحسين×، وهرب إلى البصرة وهُدمت داره في الكوفة، وبقي سنان حيّاً إلى عهد الحجاج بن يوسف الثقفي(75ـ95هـ/694ـ713م) الوالي الأموي على العراق، والتقى بالحجّاج في مجلس عقده الاخير لتكريم أصحاب البلاء الحسن، وعندما أعترف سنان بأنّ بلاءه هو قتل الإمام الحسين×، وأنّه لم يُشرِك أحداً في فعله ذلك، عندها لم يكرمه الحجاج وطرده، ورجع إلى بيته، واعتُقِل لسانه وذهب عقله، ويُحدِث في مكانه. يُنظر: يحيى بن معين، تاريخ: ج1، ص361؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: ص25؛ السمعاني، الأنساب: ج5، ص619؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج12، ص143؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص58؛ ابن خلدون، تاريخ: ج3، ص26.
[186] هو خولّي بن يزيد الأصبحي من حمير، ولم توجد له ترجمة وافية في المصادر التي بين أيدينا، ويبدو أنّه كان جنديّاً عاديّاً في جيش ابن سعد، وما ذُكر عنه هو حزّ رأس الحسين أو حمله إلى ابن زياد في الكوفة، كما أنّه قتل اثنين من أولاد الإمام علي بن أبي طالب× يوم عاشوراء، هما جعفر وعثمان أخوا العبّاس، وأمّهما أمّ البنين. وكانت نهاية خولّي على يد المختار الثقفي، الذي كان يتتبّع قتلة الحسين ويقتصّ منهم، وعندما تمّت مداهمة بيته دلّت على مخبأه زوجته، فمسكوه وقتلوه. يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص374؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص206؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص541؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم: ج2، ص180؛ التبريزي، الاكمال في أسماء الرجال: ص44؛ الصفدي، الوافي بالوفيّات: ج13، ص273.
[187] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص200؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: ص25؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص585.
[188] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص141؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص402؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص425.
[189] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص200ـ201؛ البلاذري، أنساب الأشراف ج3، ص409ـ410؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص346؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص432؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص459ـ460.
[190] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص75؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص541؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص119؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج4، ص380.
[191] الدينوري، الأخبار الطوال: ص258.
[192] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص200؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص346؛ ابن قتيبة، المعارف: ص213؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص62؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص79؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص341؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص78؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص188.
[193] شمر ابن ذي الجوشن اسمه شرحبيل بن قرط الضبابي الكلابي أبو السابغة، من كبار قتلة الإمام الحسين×، كان في أول أمره من ذوي الرياسة في هوازن موصوفا بالشجاعة، ويُعدّ من التابعين وأباه من الصحابة، وإنّ إسلام الأخير كان بعد فتح مكّة، وشهد الشمر يوم صفّين مع الإمام علي× يقود إحدى كتائب الجيش، وبعد استشهاد الإمام علي بن أبي طالب× تغيّر الشمر وأصبح يميل إلى الأمويين، وكان من بين الأمراء الأمويين الذين خذّلوا النّاس عن نصرة مسلم بن عقيل× في الكوفة، وكانت نهاية الشمر على يد المختار الثقفي. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج2، ص303؛ ابن سعد، الطبقات: ج6، ص46؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص276؛ الطبراني، المعجم الكبير: ج7، ص307؛ الذهبي، ميزان الاعتدال: ج2، ص280.
[194] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص114؛ ابن سعد، الطبقات: ج6، ص47؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص219؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص321؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص146؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص41؛ الذهبي، ميزان الاعتدال: ج2، ص280.
[195] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص141؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص334؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص78.
[196] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص202؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص410؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص347؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص259؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص44؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص86.
[197] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص203؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص206؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص259؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4 ص348؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص113؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص44؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص326؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص64؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص84؛ ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2630.
[198] يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية: ج3، ص799؛ ابن سعد، الطبقات: ج8، ص16؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص301ـ302؛ الطبراني، الأحاديث الطوال: ص14ـ16؛ الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القران: ج9، ص51ـ52؛ البغوي، معالم التنزيل: ج4، ص196؛ الطبرسي مجمع البيان: ج9، ص203؛ ابن قدامه، المغني: ج12، ص340؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج5، ص490.
[199] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص340؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج1، ص213.
[200] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص340؛ ابن منظور، لسان العرب: ج14، ص368.
[201] ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج2، ص340؛ الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج1، ص265؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج1، ص213.
[202] الفراهيدي، العين: ج7، ص313؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص340.
[203] الفراهيدي، العين: ج7، ص313؛ الزمخشري، أساس البلاغة: ص421.
[204] ابن منظور، لسان العرب: ج14، ص368؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص340.
[205] الزبيدي، تاج العروس: ج19، ص505.
[206] الجوهري، الصحاح: ج6، ص2371؛ عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب: ج9، ص230.
[207] الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ج9، ص134.
[208] الأحزاب: آية26.
[209] الانفال: آية66.
[210] يُنظر: إبراهيم شمس الدين، مجموع أيّام العرب في الجاهلية والإسلام: ص14.
[211] يُنظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى، أيّام العرب قبل الإسلام: ج2، ص157ـ159؛ الشمشاطي، الأنوار ومحاسن الأشعار: ص45، 78؛ إبراهيم شمس الدين، مجموع أيّام العرب في الجاهلية والإسلام: ص76، 84.
[212] ابن منظور، لسان العرب: ج14، ص368.
[213] أحمد بن حنبل، مسند أحمد: ج6، ص165؛ ابن خزيمة، صحيح: ج4، ص359؛ الطبراني، المعجم الأوسط: ج2، ص83؛ البيهقي، السنن الكبرى: ج4، ص350؛ ابن قدامه، المغني: ج10، ص366.
[214] عبد السلام الترمانيني، الرقّ ماضيه وحاضره: ص32.
[215] ويل ديورانت، قصّة الحضارة: ج1، ص48؛ عبد السلام الترمانيني، الرقّ ماضيه وحاضره: ص15.
[216] الجوهري، الصحاح: ج4، ص1484؛ ابن منظور، لسان العرب: ج10، ص123، 124.
[217] الجوهري، الصحاح: ج4، ص483؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص209.
[218] الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج3، ص30؛ الزبيدي، تاج العروس: ج6، ص358.
[219] محمّد الخضري، الرقّ في الإسلام: ص7؛ التوني، محمّد محرّر العبيد: ص9.
[220] محمّد التهاوني، موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية: ص582.
[221] محمّد أبو اليسر عابدين، القول الوثيق في أمر الرقيق: ص6.
[222] محمّد عبد الله عنان، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام: ص232؛ آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام: ج1، ص314؛ رائد محمّد حامد، الرقيق في صدر الإسلام والدولة الأموية: ص115.
[223] عبد السلام الترمانيني، الرقّ ماضيه وحاضره: ص37.
[224] المصدر السابق: ص15.
[225] ويل ديورانت، قصّة الحضارة: ج1، ص37.
[226] عبد السلام الترمانيني، الرقّ ماضيه وحاضره: ص38.
[227] أسواق النخاسة، وهي الأسواق التي يُباع فيها الأسرى والسبايا، والذين يقومون بعملية البيع والشراء يُسمَّون بالنخاس، وهم الذين يبيعون الدواب، وسُمّوا بذلك لنخسهم إيّاها حتى تنشط، وحرفتهم النخاسة، ويُسمّى بائع الرقيق نخّاساً. ابن منظور، لسان العرب: ج3، ص603.
[228] أحمد شلبي، مقارنة الأديان (الإسلام): ص232.
[229] عبد السلام الترمانيني، الرقّ ماضيه وحاضره: ص17.
[230] ويل ديورانت، قصّة الحضارة: ج3، ص48؛ رستوفتزف، تاريخ الامبراطورية الرومانية الاجتماعي والاقتصادي: ج1، ص16.
[231] ويل ديورانت، قصّة الحضارة: ج 3، ص48؛ عبد السلام الترمانيني، الرقّ ماضيه وحاضره: ص54؛ شادي ابراهيم، السبي في صدر الإسلام: ص10.
[232] أحمد شلبي، مقارنة الأديان (الإسلام): ص232؛ عبد السلام الترمانيني، الرقّ ماضيه وحاضره: ص54؛ علي كسّار، الجذور التاريخية لظاهرة الرقّ عند الشعوب القديمة وعرب الجزيرة قبل الإسلام: ص48.
[233] أحمد شلبي، مقارنة الأديان (الإسلام): ص232؛ عبد السلام الترمانيني، الرقّ ماضيه وحاضره: ص87.
[234] هو أحد أباطرة بيزنطة، تولّى الحكم بعد وفاة عمّه جستن الأول، ومن أعماله إصلاحه للقوانين، وعُرفت في ما بعد باسمه، كقانون جستنيان، وقد توسّعت دولته في عهده. يُنظر: محمود سعيد عمران، تاريخ الامبراطورية البيزنطينية: ص46؛ ساليفان، ورثة الامبراطورية الرومانية: ص51.
[235] ويل ديورانت، قصّة الحضارة: ج4، ص227؛ شادي ابراهيم، السبي في صدر الإسلام: ص10.
[236] هي خماني بنت بهمن بن سفنديار، تولّت الملك لكمال عقلها وبهائها وفروسيتها ونجدتها، وإحسان أبيها لرعيته، وكانت تلقّب بشهرزاد. يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص406؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج1، ص421.
[237] الدينوري، الأخبار الطوال: ص27؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص406؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج1، ص421.
[238] هو سابور ذو الاكتاف بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن هرمز بن سابور بن اردشير، تولّى الملك بوصية أبيه، وعند تولّيه الملك أبقى على وزراء وكتّاب أبيه. يُنظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج1، ص163؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص490.
[239] ابن قتيبة، المعارف: ص658؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص491؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم: ج1، ص149.
[240] ابن الجوزي، المنتظم: ج2، ص84.
[241] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج1، ص495؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج2، ص78. ومدينة إيران شهر سابور، أسماها سابور باسمه، وهي بالكسر وراء والف ونون ساكنتان، وفتح الشين المعجمة، وهاء ساكنة، وراء أخرى، ويقصد بالاسم(إيران شهر) أقاليم العراق وفارس والجبال وخراسان، والفرس تقول: إيران اسم أرفخشد بن سام بن نوح، وشهر يعني البلد، فهو اسم مركّب معناه بلاد أرفخشد. يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص289.
[242] محمود شكري الآلوسي، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: ج2، ص288؛ أحمد إبراهيم الشريف، مكّة والمدينة في الجاهلية وعصر الرسول (صلى الله عليه وسلم): ص168.
[243] جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج5، ص341.
[244] فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج3، ص403؛ شيماء فاضل عبد الله الحميدي، البداوة قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية: ص157.
[245] عن هذه الأيّام يُنظر: إبراهيم شمس الدين، مجموع أيّام العرب في الجاهلية والإسلام: ص37، 76، 78، 81، 82، 83، 109.
[246] جواد علي، المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ج5، ص632.
[247] المصدر السابق.
[248] الواقدي، المغازي: ج1، ص115؛ ابن كثير، السيرة النبوية: ج2، ص471. وبدر، بالفتح ثمّ السكون، وهو موضع ماء مشهور بين مكّة والمدينة أسفل وادي الصفراء، ووقعت في هذا المكان معركة بدر بين المسلمين والمشركين في عام 2هـ/623م، وكان النصر حليف المسلمين. يُنظر: الواقدي، المغازي: ج1، ص19؛ ابن هشام، السيرة: ج2، ص440؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص131؛ ياقوت، معجم البلدان: ج1، ص357؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج2، ص216؛ المقريزي، إمتاع الأسماع: ج8، ص340.
[249] المقريزي، إمتاع الأسماع: ج1، ص253؛ الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد: ج5، ص15.
[250] بالكسر ثمّ السكون، مقصور، يجوز أن يكون أصله من الحسم وهو المنع، وهو أرض ببادية الشام، بينها وبين وادي القرى ليلتان. يُنظر: أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج2، ص446؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص258.
[251] الواقدي، المغازي: ج1، ص558؛ ابن سعد، غزوات الرسول’وسراياه: ص88؛ ابن سيد النّاس، السيرة النبوية: ج2، ص101.
[252] ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج2، ص152؛ ابن سيد النّاس، السيرة النبوية: ج2، ص219. حنين: وهي المعركة التي أنتصر فيها المسلمون على المشركين عام 8هـ/629م. يُنظر: الواقدي، المغازي: ج2، ص885؛ ابن هشام، السيرة: ج4، ص889.
[253] الواقدي، المغازي: ج2، ص943؛ ابن هشام، السيرة النبوية ج4، ص925؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج2، ص88؛ المقريزي، إمتاع الأسماع: ج1، ص253.
[254] محمّد جابر الحيني، دراسات إسلامية في القرآن الكريم: ص46.
[255] الحجرات: آية13.
[256] أحمد شلبي، مقارنة الأديان (الإسلام): ص236.
[257] محمد: آية4.
[258] السرخسي، شرح السير الكبير: ج1، ص297.
[259] ابن سعد، الطبقات: ج2، ص22؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج3، ص110؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج17، ص56.
[260] لقد مَنَّ الرسول’ على أبي عزّة عمرو بن عبد الله الجمحي عندما وقع في الأسر بمعركة بدر، وأطلق سراحه؛ لأنّه كان فقيراً وكثير البنات، وأخذ منه عهداً بأن لا يقاتله بعد ذلك، إلّا أنّ عبد الله الجمحي لم يفِ بذلك وقاتل المسلمين في معركة أحد، ووقع في الأسر، ممّا جعل الرسول’ يعاقبه بالقتل؛ لعدم إيفائه بالعهد. يُنظر: الزبيري، نسب قريش: ص397.
[261] معنى الكتابة في الشرع هي: أن يُكاتِب الرجلُ عبدَه على مال يُؤدّيه مُنَجَّماً عليه، فإذا أدّاه فهو حرّ. والمنُجَّم من الديون هو: الذي يُقدّر أداؤه في أوقات متتابعة شهرياً، أو سنوياً، وأصله أنّ العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها، مواقيت حلول ديونها، فيقولون إذا طلع النجم حلّ عليك مالي. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج12، ص244؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج9، ص38؛ أحمد شلبي، مقارنة الأديان (الإسلام): ص241.
[262] سليمان حريتاني، الجواري والقيان: ص30.
[263] النور: آية33.
[264] النساء: آية36.
[265] الكليني، الكافي: ج5، ص114؛ العلّامة الحلّي، منتهى الطلب: ج2، ص1018؛ محمّد بن مكّي الشهيد الأول، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: ج3، ص218؛ المتّقي الهندي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج4، ص22.
[266] ابن حنبل، المسند: ج5، ص411.
[267] مالك، الموطأ: ص835.
[268] ابن حنبل، المسند: ج5، ص10؛ الدارمي، السنن: ج2، ص191.
[269] البخاري، الصحيح: ج1، ص13؛ البيهقي، شعب الإيمان: ج6، ص371؛ ومعرفة السنن والآثار: ج6، ص127؛ العيني، عمدة القارئ: ج1، ص402.
[270] الحارث بن ضرار الخزاعي، ويُقال الحارث بن أبي ضرار المصطلقي، سكن الحجاز، وله صحبه. يُنظر: البخاري، التاريخ الكبير: ج2، ص261؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ج3، ص434؛ ابن حبّان، الثقات: ج3، ص76؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج1، ص293؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص165.
[271] ابن سعد، الطبقات: ج8، ص117؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص101.
[272] هـو من الكرماء الاجواد، ويصل نسبه إلى قحطان، ويُكنّى أبا طريف أو أبا وهب، وكان سيّداً شريفاً خطيباً حكيماً في قومه، جاء إلى النبي، وأكرمه وقرّبه ووسّع له في مجلسه، وسأل النبي عن أشياء فأجابه عنها، فأعلن إسلامه، وفي سنة 10هـ/631م بعثه النبي على صدقات طي وأسد، وروى عدي عن النبي وعمر وعلي، وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، وقد شهد فتوح العراق والشام وفارس، وأُمّر على بعض الكتائب، ونزل الكوفة وسكنها، وكان من خيار أصحاب الإمام علي بن أبي طالب×، شهد معه كلّ معاركه، وذهبت عينه في واقعة الجمل، وانضم إلى الإمام الحسن بن علي×، تُوفي عدي في الكوفة سنة 66هـ/685م أو 67هـ/686م. يُنظر: الطبري، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: ص44؛ الطبراني، المعجم الكبير: ج17، ص68؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص1057؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج1، ص202.
[273] الطبراني، الأحاديث الطوال: ص16.
[274] هو أحد حصون خيبر، ويُسمّى أيضاً بحصن السلالم أو القموص، وقد تمّ فتحه في سنة (7هـ/628 م)، وقد أصاب رسول الله منهم سبايا. يُنظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص49؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص298؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج3، ص294.
[275] صفيّة بنت حيي بن أخطب بن سعية بن عامر بن عبيد بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم، من بني إسرائيل من سبط هارون بن عمران، وأمّها برة بنت سموأل أخت رفاعة بن سموأل من بني قريظة إخوة النضير، وكانت متزوّجة من سلام بن مشكم القرظي، ثمّ فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق النضري فقُتل عنها يوم خيبر، أعتقها رسول الله وتزوّجها وجعل عتقها مهرها، وتُوفّيت صفيّة سنة 52هـ/672 م في عهد معاوية بن أبي سفيان، ودُفنت بالبقيع. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج8، ص121؛ ابن حبان، الثقات: ج2، ص139؛ ابن أيوب الباجي، التعديل والتجريح: ج3، ص1494.
[276] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص302؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج18، ص137.
[277] يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية: ج3، ص701، 704؛ ابن قتيبة، المعارف: ص144؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج19، ص350؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج2، ص60؛ نجمان ياسين، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة: ص113؛ رائد محمّد حامد، الرقيق في صدر الإسلام والدولة الأموية: ص24ـ45.
[278] يُنظر: ابن قتيبة، المعارف: ص144؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج1، ص467؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج19، ص353؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج2، ص224، و ج5، ص530ـ531؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج3، ص111، و ج8، ص281ـ282؛ جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام: ص158؛ محمّد عبد الله عنان، مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام: ص234؛ نجمان ياسين، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة: ص149؛ رائد محمّد حامد، الرقيق في صدر الإسلام والدولة الأموية: ص70ـ93.
[279] تفاصيل أوسع عن ذلك يُنظر: فان فلوتن، السيادة العربية والشيعة والأسرائيليات في عهد بني أميّة: ص37؛ عبد الحي الكتاني، نظام الحكومة النبوية: ج2، ص51ـ52؛ جواد علي، تاريخ العرب في الإسلام: ص52؛ عبدالله عبد العزيز بن ادريس، مجتمع المدينة في عهد الرسول: ص224؛ نجمان ياسين، التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في المدينة: ص166؛ رائد محمّد حامد، الرقيق في صدر الإسلام والدولة الأموية: ص47ـ69.
[280] تفاصيل أوسع عن ذلك يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج6، ص304، و ج7، ص156؛ ابن الجوزي، كشف المشكل من حديث الصحيحين: ج3، ص578؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج7، ص109؛ الهيثمي، موارد الظمان: ج5، ص388ـ389؛ رائد محمّد حامد، الرقيق في صدر الإسلام والدولة الأموية: ص94ـ112.
[281] العين: ج4، ص89.
[282] القصص: آية29.
[283] المدثر: آية56.
[284] ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص150؛ ابن منظور، لسان العرب: ج11، ص29.
[285] الصحاح: ج4، ص1627.
[286] معجم مقاييس اللغة: ج1، ص160.
[287] الفائق في غريب الحديث: ج1، ص61.
[288] لسان العرب: ج11، ص30.
[289] الزمخشري، الفائق في غريب الحديث: ج1، ص61؛ ابن منظور، لسان العرب: ج11، ص30.
[290] غافر: آية28.
[291] تهذيب اللغة: ص437.
[292] الصحاح: ج14، ص1627.
[293] الزبيدي، تاج العروس: ج14، ص36ـ37.
[294] هود: آية73.
[295] القصص: آية12.
[296] الأحزاب: آية33.
[297] البقرة: آية248.
[298] آل عمران: آية11.
[299] يوسف: آية6.
[300] النمل: آية56.
[301] آل عمران: آية33.
[302] ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص538.
[303] النهاية في غريب الحديث: ج3، ص177.
[304] لسان العرب: ج4، ص538.
[305] المسند: ج2، ص232.
[306] الأحزاب: آية33.
[307] بكسر الميم، واحد المروط، وهي: أكسية من صوف أو خزّ كان يُؤتزر بها. الفراهيدي، العين: ج7، ص426؛ الرازي، مختار الصحاح: ص318؛ ابن منظور، لسان العرب: ج7، ص399.
[308]أبو شيبة، المصنف: ج7، ص501؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج3، ص147؛ ابن البطريق، خصائص الوحي المبين: ص101.
[309] الحامّة: الخاصّة، الأقرباء. يُنظر: النحاس، معاني القرآن: ج5، ص90؛ الجوهري، الصحاح: ج5، ص1907.
[310] الترمذي، سنن الترمذي: ج5، ص31؛ ابن العربي، أحكام القرآن: ج3، ص571.
[311] الطوسي، الأمالي: ص559؛ نور الله المرعشي، شرح إحقاق الحقّ: ج14، ص59؛ محمّد الريشهري، أهل البيت في الكتاب والسنّة: ص58.
[312] هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الانصاري، وُلِد قبل الهجرة بعشر سنوات، من الحفاظ المكثرين، ومن العلماء الفضلاء، ويُعدّ من فقهاء الصحابة، شهد بيعة الشجرة واثنتي عشرة غزوة مع النبي’، وروى عن النبي’ وعن أبي بكر وعمر وعثمان والإمام علي×، واختُلِف في وفاته، البعض يذكر أنّه تُوفِّي عام 74هـ/693م، وقيل: عام 64هـ/684م، أو عام 63هـ/683م، وقيل: 65هـ/685م. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج6، ص6؛ ابن قتيبة، المعارف: ص153؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج2، ص289؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص35.
[313] الحسكاني، شواهد التنزيل: ج2، ص38. وواثلة بن الاسقع بن كعب بن عامر، وقيل: واثلة بن الاسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل بن ناشد الليثي، من أصحاب الصفّة، أسلم سنة 9هـ/630م، وشهد معركة تبوك، وتُوفّي سنة 83هـ/702م وله 98 سنة. يُنظر: خليفة بن خياط، الطبقات: ج1، ص69؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص525. تفاصيل أوسع عن أهل الصفّة يُنظر: ختام راهي مزهر، أهل الصفّة في الإسلام دراسة في أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية حتى العصر الراشدي؛ عمر فلاح عبد الجبار عطاوي، أهل الصفّة في عصر الرسالة والراشدي: ص15ـ244.
[314] إبراهيم القمّي، تفسير القمّي: ج2، ص67؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج4، ص290؛ ابن طاووس، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: ص128.
[315] الطبراني، المعجم الكبير: ج22، ص200؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج2، ص134؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج5، ص343؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص309.
[316] المحسن بن كرامة، تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين: ص110.
[317] الصدوق، كمال الدين وإتمام النعمة: ص206؛ هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن: ج4، ص195؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج36، ص254.
[318] حسين القمّي، العقد النضيد والدرّ الفريد في فضائل أمير المؤمنين وأهل البيت: ص78.
[319] الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب الحديث: ص151.
[320] سُمّي الباب بهذا الاسم نسبة إلى توما أحد عظماء الروم، وهي الباب التي دخل منها يزيد بن أبي سفيان عند حصار دمشق، وذلك في عهد أبي بكر (11ـ13هـ/632ـ634م). يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج2، ص407؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص307؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص143.
[321] سنذكر هذه الآيات في صفحات قادمة، تحديدا عند دخول سبايا أهل البيت إلى دمشق، وذكر حوار الإمام علي بن الحسين÷ مع الرجل الشامي.
[322] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص103؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص102.
[323] رضا بن نبي القزويني، تظلّم الزهراء: ص217.
[324] عبد الله بن عفيف، من الأزد من غامد ومن بني والبة، وهو من خِيار الشيعة وأفاضلهم، له صحبة مع رسول الله، وقد ذهبت عينه اليسرى في يوم الجمل والأخرى في يوم صفّين، وكان لا يُفارق مسجد الكوفة الأعظم، حيث يصلّي فيه إلى الليل ثمّ ينصرف إلى منزله. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص210؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص351؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص96؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص328؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص466.
[325] يُنظر: الفصل الثاني: ص229.
[326] الشورى: آية23.
[327] الحسكاني، شواهد التنزيل: ج2، ص130؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج6، ص16؛ السيوطي، الدرّ المنثور: ج7، ص300.
[328] ابن المغازلي، مناقب الإمام علي: ص105. وقريب منه يُنظر: محبّ الدين الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة: ج2، ص189.
[329] ابن حنبل، المسند: ج3، ص394؛ الصدوق، الخصال: ص487؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك: ج3، ص160ـ161؛ الطوسي، الخلاف: ج1، ص27؛ ابن البرّاج، المهذّب: ج1، ص18؛ سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ص46.
[330] ابن حجر الهيثمي، الصواعق المحرقة في الردّ على أهل البدع والزندقة: ص202.
[331] ابن حنبل، المسند: ج5، ص492؛ البيهقي، السنن الكبرى: ج2، ص148.
[332] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص335.
[333] الكليني، الكافي: ج3، ص74؛ الطوسي، الأمالي: ص735؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج7، ص97.
[334] يُقصد به ذلك الرجل الذي ينتمي إلى فرقة الخوارج، وهم الجماعة التي انفصلت عن جيش الإمام علي بن أبي طالب× الخليفة الشرعي، إبّان الحرب مع معاوية بن أبي سفيان والي الشام المعزول في معركة صفّين سنة 37هـ/657م، ورفضت التحكيم ونتائجه، ودخل الإمام علي معهم في معركة النهروان سنة 38هـ/658م، ولم يتمّ القضاء عليهم نهائياً، بل انتشر ما تبقّى منهم في الكوفة والبصرة والأحواز (الأهواز) والمشرق والمغرب الإسلاميين، وخلال ربع قرن من الزمن التفّ حولهم كثير من الأتباع، ومعظمهم من الموالي المتذمّرين من اجراءات السلطة الأموية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، وأصبحوا خلال هذه المدّة عبارة عن حركة سياسية دينية فكرية، وكانوا ينظرون إلى الخلفاء الأمويين وأُمرائهم وولاتهم أنّهم غير شرعيين، منحرفون عن الدين ومخالفون لقواعده، وقد أربكت حركة الخوارج السلطة الأموية طوال مدّة حكمهم من خلال المعارك التي خاضوها مع السلطة، وقد انقسم الخوارج على أنفسهم إلى عدد من الفِرَق، مثل الأزارقة المتطرّفة، والصفرية والنجدات والأباضية. عن الخوارج وفِرَقهم ومبادئهم السياسية والدينية ومعاركهم يُنظر: الكرماني، الفِرَق الإسلامية، ذيل كتاب شرح المواقف، للكرماني: ص65؛ صابر طعيمة، الأباضية عقيدة ومذهباً: ص17ـ161؛ محمّد رضا الدجيلي، الأزارقة؛ أسماء غني عبد الله العزاوي، نشاط الخوارج في البصرة والأحواز خلال القرن الأول الهجري؛ ستّار جبّار علوان، الأحوال السياسية والحضارية في أقليم كرمان حتى نهاية القرن الرابع الهجري: ص228.
[335] أنصار الحسين دراسة عن شهداء ثورة الحسين الرجال والدلالات: ص184.
[336] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص203؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص84.
[337] مفردها القتب، وهو الرحل الصغير على قدر السنام. ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص160.
[338] وهو خلاف الغطاء، أي بدون غطاء. الجوهري، الصحاح: ج1، ص81.
[339] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص203؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص44؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص174؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص365؛ بحر العلوم، في رحاب السيّدة زينب‘: ص148؛ مظفر عبد العالي، الفتح والاستشهاد في ذكرى الإمام الحسين×: ص219.
[340] الحسن المثنّى بن الحسن السبط بن علي، كان مع عمّه الإمام الحسين× يوم الطفّ، وقد أُسِر بعد أن جُرح عدّة جراحات، وشفي منها فيما بعد، وقيل عند اصابته أخذه أخواله من بني خارجة الفزاري؛ لأنّ أمّه فزارية، وتركه لهم ابن سعد، ولمّا شُفي أرسلوه إلى أهله في المدينة. يُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص174؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص365.
[341] ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص77.
[342] المرقع بن ثمامة بن أثال الصيداوي، لحق بالحسين× وقاتل بين يديه. الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص347؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص80؛ علي الكوراني، قبيلة بني أسد: ص46.
[343] وقيل: إنّ ابن زياد نفاه إلى الزارة، وهي قرية كبيرة في البحرين. البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص205؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص347؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص126.
[344] أشارت بعض الروايات إلى أنّ المرقع أخرجه قومه من المعركة بعد أن نفدت نباله، وجُرح عدّة جراحات، ولم يؤسر، وفي الكوفة أخبر ابنُ سعد خبرَه ابنَ زياد فنفاه. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص205؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص347؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص184.
[345] الأخبار الطوال: ص259.
[346] العقد الفريد: ج5، ص131ـ134؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص78.
[347] وهناك مَن يذكر بأنّ عبد الله بن الحسن قد قُتِل يوم الطفّ. يُنظر: الطبرسي، أعلام الورى: ص127؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص264.
[348] شرح الأخبار: ج3، ص197.
[349] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص356.
[350] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص8؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص228؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص253.
[351] موسوعة كربلاء: ج1، ص527.
[352] عن سيرة علي الأكبر، يُنظر: عبد الرزاق المقرّم، علي الأكبر.
[353] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص18؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل في تاريخ الصحابة والتابعين: ص25؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج2، ص249.
[354] لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص527.
[355] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج29، ص75؛ ابن الصبّاغ المالكي، الفصول المهمّة: ج1، ص647؛ ذبيح الله المحلاتي، رياحين الشريعة في ترجمة علامات نساء الشيعة: ج3، ص30؛ محمّد الحسّون، أعلام النساء المؤمنات: ص716.
[356] هـو المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب بن هاشم القرشي، وكنيته أبو يحيى أو أبو حليمة، صحابي وُلد قبل الهجرة، أو بعدهـا باربع سنين، وقيل: إنّه لم يُدرك من حياة النبي إلّا ستّ سنين، وروى عن النبي، وقيل: إنّ حديثه مرسل، وكان قاضي المدينة في عهد عثمان بن عفّان (23ـ35هـ/643ـ655م)، وشهد صفّين إلى جانب الإمام علي، واتّصف بقوته الشديدة، فلمّا ضرب بن ملجم الإمام علياً في مسجد الكوفة، وحاول الهرب تمكّن منه المغيرة، وألقى عليه قطيفة، وأمسك به وأخذ سيفه، وضرب به الارض، وتُوفّي المغيرة سنة 50هـ/670م. يُنظر: ابن عبد البر، الاستيعاب: ج4، ص1448؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج4، ص408؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج4، ص125؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج6، ص158؛ أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث: ج19، ص304.
[357] البلاذري، أنساب الأشراف: ج2، ص33؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج4، ص1448؛ الصالحي الشامي، سبل الهدى والرشاد: ج11، ص32؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج1، ص335.
[358] الزبيري، نسب قريش: ص83؛ ابن قتيبة، المعارف: ص119؛ الديار بكري، تاريخ الخميس: ج2، ص317.
[359] عباس القمّي، نفس المهموم: ص286؛ عبد الرزاق المقرّم، علي الاكبر: ص15.
[360] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص18؛ ابن قتيبة، المعارف: ص113ـ115؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص146؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص25؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص137؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص362؛ المشغري، الدر النظيم: ص575؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج2، ص249؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج109: ص96.
[361] لباب الأنساب والألقاب والأعقاب: ج1، ص350.
[362] المصدر السابق: ص51.
[363] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص361؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص41؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج20، ص230.
[364] المسعودي، إثبات الوصية: ص181.
[365] ابن داود، رجال: ص202؛ المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج3، ص163؛ محمّد تقي التستري، قاموس الرجال: ج11، ص31.
[366] لباب الأنساب والألقاب والأعقاب: ج1، ص355.
[367] نبيل الحسني، سبايا آل محمد’، دراسة في تاريخ سبي النساء وعلّة إخراج الإمام الحسين× عياله إلى كربلاء: ص135.
[368] محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص136؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص529ـ530.
[369] محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص135؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص528ـ529.
[370] محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص135؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص529.
[371] إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص424؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص530ـ531.
[372] إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص428؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص531.
[373] إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص429؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص531.
[374] المصدران السابقان.
[375] المصدران السابقان.
[376] محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص140؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص533.
[377] كان للإمام الحسين× ستّة أولاد، وهم، علي الاكبر، قتل مع أبيه يوم الطفّ، وعلي الاصغر(السجّاد) ويكنّى أبا محمّد، وجعفر، وقد تُوفّي في حياة أبيه، وعبد الله الرضيع، قُتِل يوم الطفّ صغيراً، وسكينة، وفاطمة، ولم نجد للحسين ولداً بإسم علي الأوسط في المصادر التي بين أيدينا. يُنظر: ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص18؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: ص25؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص362.
[378] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص18؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: ص25؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص362.
[379] محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص140؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص533ـ534.
[380] إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص427؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص534.
[381] إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص52؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج1، ص526.
[382] محمّد السماوي، إبصار العين في أنصار الحسين×: ص228؛ جواد محدثي، موسوعة عاشوراء: ص230.
[383] عن قبيلة بني أسد يُنظر: مهدي عريبي الدخيلي، بني أسد ودورهم في التاريخ العربي الإسلامي.
[384] هـو علي بن مظاهر الاسدي، أخو حبيب بن مظاهر، وقد قُتِل الاثنان في الطفّ. النمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث: ج5، ص408.
[385] محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص313؛ محمّد الحسّون، أعلام النساء المؤمنات: ص130؛ عبد الله الحسن، ليلة عاشوراء في الحديث والأدب: ص53؛ عبد العظيم المهتدي البحراني، من أخلاق الإمام الحسين×: ص280.
[386] ذبيح الله المحلاتي، فرسان الهيجاء في تراجم أصحاب سيد الشهداء: ج1، ص364؛ إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص179؛ حسين نعمة أبو هلالة، أنصار الإمام الحسين×في واقعة كربلاء من غير الهاشميين، دراسة في أحوالهم العامّة: ص65.
[387] عن سيرة حبيب بن مظاهر يُنظر: المظفّر، البطل الأسدي حبيب بن مظاهر؛ علي عبد الستار، هاشم ناصر، حبيب بن مظاهر الاسدي ودوره في واقعة الطف: ص169ـ170.
[388] ابن أعثم، الفتوح: ج2، ص145؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص345؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص386؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص229.
[389] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص180؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج1، ص345.
[390] مسلم بن عوسجة: صحابي رأى النبي وروى عنه، كان عابداً متنسّكاً، يقضي يومه في مسجد الكوفة الأعظم للعبادة، وجاهد مع المسلمين الفاتحين لاقليم اذربيجان، وكان مسلم وحبيب ياخذان البيعة للإمام الحسين× في الكوفة، وخرجا سويةً متخفيينِ يسيرانِ في الليل، ويكمنان في النهار، حتى وصلا الطفّ. الدينوري، الأخبار الطوال: ص235؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج4، ص264؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج7، ص280.
[391] القرّاء، ومفرده قارئ، اشتقّ هذا المصطلح من القرآن الكريم، وهم الذين يقرؤن ويحفظون القرآن الكريم، ويدرسونه تعبّداً لله تعالى، ويبذلون جهداً في ذلك، ويتمسّكون بشعائر الدين أكثر من غيرهم، وكان الواحد منهم عالماً بعلوم اللسان العربي من اللغة والإعراب والفصاحة شعراً ونثراً، وعلوم الشريعة فقهاً وتفسيراً وحديثاً. يُنظر: هادي حسن حمود، القرّاء ودورهم في الحياة العامّة في صدر الإسلام والخلافة الأموية: ص1ـ66.
[392] إيمان أحمد جابر اللامي، خطب وأقوال أهل البيت في واقعة الطفّ ـ دراسة تاريخية: ص140.
[393] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص25؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص27؛ محسن الأمين، لواعج الاشجان: ص264.
[394] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص193؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص332.
[395] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص327، 333؛ الصدوق، الأمالي: ص98؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص16؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص172؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص161؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص282.
[396] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص124؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص190؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص327؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص104؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص65؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص196؛ ذبيح الله المحلاتي، رياحين الشريعة في ترجمة علامات نساء الشيعة: ج3، ص30.
[397] محمّد تقي التستري، قاموس الرجال: ج9، ص260، 263، 267؛ حسين أبو هلالة، أنصار الإمام الحسين×: ص54.
[398] عبد الله بن عمير الكلبي، هـو من المجاهدين المسلمين في الفتوحات الإسلامية، وكانت داره في الكوفة، ومن الذين التحقوا بمعسكر الإمام الحسين×، تصحبه زوجته وتشجعه على ذلك، عشيّة الثامن من المحرّم، وكان رأيه بأنّ الجهاد بين يدي الإمام الحسين× أكثر ثواباً عند الله تعالى من جهاد المشركين. يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص321؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص280.
[399] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص326؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص101؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص172.
[400] ابن شهر آشوب، مناقب: ج4، ص101؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص17.
[401] جنادة بن كعب بن الحرث الخزرجي الأنصاري، صاحب رسول الله’، استُشهِد مع الإمام الحسين× سنة 61هـ/680 م في الحملة الأولى. ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص110؛ محمّد السماوي، إبصار العين: ص158؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج4، ص224.
[402] الرسان، التسميّة: ص153؛ الشجري، الأمالي الخميسية: ج1، ص172؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص25.
[403] ابن أعثم، الفتوح: ج2، ص163؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص26؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص104؛ عبد الله المامقاني، تنقيح المقال في علم الرجال: ج2، ص326.
[404] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص26؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص607؛ مرتضى العسكري، معالم المدرستين: ج3، ص121.
[405] لمزيد من التفاصيل عن ذلك يُنظر: حسين أبو هلالة، أنصار الإمام الحسين× من غير الهاشميين: ص101ـ107.
[406] الطبرسي، أعلام الورى: ص250.
[407] مقتل الحسين×: ص232؛ وكذلك يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص358؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص91؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص461؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ج2، ص849.
[408] أنساب الأشراف: ج3، ص207.
[409] الأخبار الطوال: ص259؛ وكذلك يُنظر: ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2630.
[410] اللهوف في قتلى الطفوف: ص85.
[411] تذكرة الخواص: ص326.
[412] المصدر السابق: ص329.
[413] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص358.
[414] حسين أبو هلالة، أنصار الإمام الحسين× من غير الهاشميين: ص101.
[415] إيمان أحمد جابر اللامي، خطب وأقوال أهل البيت في واقعة الطفّ ـ دراسة تاريخية: ص142.
[416] حميد بن مسلم الازدي، هـو من الذين نقلوا جملة من أحداث معركة الطفّ، كشاهد عيان؛ لأنّه كان حاضراً فيها في صفوف جيش ابن سعد، إذ كان يقوم بما يشبه دور المؤرّخ في نقله للأخبار، وبعد الطفّ خرج مع التوابين، ولم يؤثر منه موقف قتالي، وعاد مع العائدين، ثمّ انضم إلى إبراهيم بن مالك الأشتر، القائد العسكري للمختار الثقفي، وعندما بدأ الأخير يتتبّع قتلة الإمام الحسين× فرّ حميد بن مسلم من الكوفة، ولم يرجع اليها إلّا بعد سيطرة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (65ـ86هـ/684ـ705م) عليها. يُنظر: محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج6، ص255؛ الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث: ج2، ص289؛ أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث: ج7، ص312؛ آل سيف، من قضايا ثورة الإمام الحسين×، شبكة الإمامين الحسنين www. alhassanain. com: ج2، ص82.
[417] لم نعثر لها على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[418] الإجّانة، وهي التي تُغسل فيها الثياب. يُنظر: ابن سلام، غريب الحديث: ج3، ص91؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج2، ص50.
[419] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص206؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص348؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص296؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج13، ص273؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص189؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص125؛ حسن عبد الأمير النصراوي، رأس الإمام الحسين× من الشهادة إلى الدفن: ص19.
[420] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص353.
[421] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص203ـ204؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص411؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص348ـ349؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص44؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص326.
[422] المجلسي، بحار الأنوار: ج28، ص57.
[423] سكينة هي بنت الإمام الحسين×، اسمها آمنة أو أميمة، وسكينة لقب لها، لُقّبت
به من قِبَل أمّها الرباب بنت امرئ القيس؛ لسكونها وهدوئها، إذ كانت السكينة صفةً لها. والرباب
هي من قبيلة قضاعة، وقد أسلم أبوها في عهد عمر بن الخطاب، وولّاه على مَن أسلم من
قضاعة في الشام، واتّصفت الرباب بالوفاء لزوجها الإمام الحسين×، فبعد واقعة الطفّ
بسنة واحدة تُوفّيت حزناً عليه، ولم يذكر المؤرِّخون سنة ولادة سكينة، بل ذكروا
وفاتها وهي في السبعين من عمرها، حيث تُوفيت في الخامس من ربيع الأول سنة
117هـ/735م، في المدينة المنورة ودُفِنت فيها، وهذا القول يجعل الاحتمال قائماً بأنّ
ولادتها بين سنتي 46هـ/666م و47هـ/667م، ويُقال: إنّها كانت في واقعة الطفّ بعمر
ما بين الثالث عشرة والرابع عشرة، أي أنّها ادركت سنّ الزواج في حياة أبيها، وتزوّجت
من ابن عمّها عبد الله بن الحسن السبط الذي قُتِل في معركة الطفّ، وقد عاشت في كنف
أبيها وأخيها علي (السجّاد) ت 94هـ/712م وابن أخيها محمّد الباقر ت 114هـ/732م، وبهذا
فلا غرو أنّها ورثت عنهم العبادة والتقوى والعلم والأدب والعفّة، والعزوف عن
الدنيا، واتّصفت سكينة بأنّها سيّدة نساء عصرها، وأوفرهنّ ذكاءً وعقلاً، وكانت تُزيّن
مجالس المدينة المنورة بمنزلتها، التي هي عبارة عن ندوة لتعليم العلم والفقه
والحديث، وقد وصفها الإمام الحسين× بأنّها كانت مستغرقة جلّ وقتها في ذات الله
تعالى، كما وصفها بخيرة النسوان عند وقوفه عليها يوم الطفّ وهي باكية نادبة، وإنّها
قد استأثرت بقلب الإمام الحسين×؛ لأنّها كانت مبعث أنسه وراحته. وقد ظُلِمت سكينة
في ما نُسِب إليها من حضورها مجالس الشعر والشعراء، ومن زواجها المتعدد، فهو من
صناعة الأمويين، والكلّ يعرف مدى عدائهم للعلويين، فقد حاولوا ـ من خلال الأخبار
التي اختلقوها عن السيّدة سكينة، والتي شغلت مساحة واسعة من كتب الحكايات، وملاحم
الغزل، ووسائل القصّاصين ـ
أن يحيلوا قداسة البيت العلوي إلى دناءة
أموية، فكل ما قِيل من شعر فيها فهو يعود على سكينة بنت خالد بن مصعب بن الزبير،
أو في سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف. لمزيد من التفاصيل عن سيرة السيّدة سكينة بنت
الإمام الحسين÷ يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج8، ص348؛ ابن حبيب البغدادي، المحبر:
ص438؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج 4، ص107؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص88؛ أبو
الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج14، ص170، و ج16، ص139؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب:
ص457؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج7، ص175؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج5، ص195؛
سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص249؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص396؛ ابن
كثير، البداية والنهاية: ج7، ص212؛ بنت الشاطئ، تراجم سيّدات بيت النبوّة: ص711؛
محمّد علي بن يحيى الحلو، عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقبة بسكينة: ص39ـ144؛
توفيق الفكيكي، سكينة بنت الحسين؛ عبد الرزاق المقرّم، السيّدة سكينة بنت الحسين؛ أمل
محمّد خضر، دور نساء أهل البيت: ص146.
[424] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص181.
[425] النخيلة: تصغير نخلة، موضع من مواضع الكوفة يقع بالقرب منها، وكان يُعرف قديماً باسم بر ملاحة، واليهود يسكنون فيه منذ القديم، وفي النخيلة مسجد قديم متاخم لبناية ضريح النبي حزقيال ذي الكفل، وورد ذكر النخيلة في الأحداث التي وقعت في العصر الراشدي، فقد خرج إليها الإمام علي بن أبي طالب× مراراً، عند توجّهه لمحاربة معاوية بن أبي سفيان في صفّين، وعندما سمع بمقتل عامله على الأنبار، وخطب فيها خطبته المشهورة في ذمّ أهل الكوفة، وفيها قُتِلت مجموعة من الخوارج عند مجيء معاوية إلى الكوفة. يُنظر: أبو عبيد البكري، معجم ما أستعجم: ج4، ص1350؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص278؛ أمانة مسجد النخيلة، النخيلة المسجد والمزار: ص6ـ7.
[426] الحناّنة، بفتح الحاء وتشديد النون، مؤنث الحنان، وحنّ الاشفاق ورقّة القلب، والحنّانة مشتقّة من كلمة حنا، وحنا اسم لدير نصراني قديم من أديرة الحيرة، وقد بناه المنذر بن النعمان الأول(418ـ462م)، ويُحاذي هذا الدير منارة عالية كالمرقب، تُسمّى القائم لبني أوس بن عمرو، وفيها سجن للمناذرة ملوك الحيرة، ويُقال لِمَن حُبس فيها ثوى، أي: أقام، والحناّنة مسجد من مساجد الكوفة القديمة، يقع في الزاوية، وهي موضع معروف منذ العصر الجاهلي، وفي الزاوية قبر أبي موسى الأشعري. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج7، ص722؛ حرز الدين، مراقد المعارف: ج2، ص219؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص261.
[427] إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص354؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص263.
[428] أبو مخنف، مقتل الحسين ومصرع أهل بيته واصحابه في كربلاء: ص111؛ إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص354.
[429] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص111؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص84؛ إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين: ص350؛ هاشم البحراني، مدينة المعاجز: ج4، ص122.
[430] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص111؛ هاشم البحراني، مدينة المعاجز: ج4، ص122.
[431] سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ص221.
[432] لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[433] وهي محلّة في الكوفة، وعندها صلِب يوسفُ بن عمر الثقفي(120ـ126هـ/737ـ743م) الوالي الأموي، الثائرَ زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سنة 122هـ/639م. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص481.
[434] هاشم البحراني، العوالم: ص372؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص114.
[435] فخر الدين الطريحي، المنتخب: ص336.
[436] عباس القمّي، منتهى الآمال: ج1، ص569.
[437] الطوسي، الأمالي: ص91؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص45.
[438] لم نعثر على ترجمة له في المصادر التي بين أيدينا، ونعتقد أنّه نفسه بشير بن خزيم الأسدي، الذي روى خطبة السيّدة زينب‘، ويُقال له أيضاً: بشير بن حذيم، وبعضهم يُسمّي أباه: حذام الأسدي، كما قيل: حذيم بن شريك الأسدي، وحذيم بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح التحتانية، وهو من أصحاب الإمام علي بن الحسين÷. ابن طيفور، بلاغات النساء: ص24ـ25؛ الطوسي، رجال الطوسي: ص113؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص195؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص46؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص192؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج4، ص606؛ علي النمازي الشاهرودي، مستدركات رجال الحديث: ج2، ص320؛ أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث: ج5، ص227.
[439] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص110.
[440] وهو عدم الكذب أو اختلاقه. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص373.
[441] أبو مخنف، مقتل الحسين × ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء: ص110.
[442] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص110؛ عباس القمّي، نفس المهموم: ص213؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج3، ص335.
[443] ومفردها ملاءة، وهي ملحفة تُفرش على السرير مطرّز، وبعضهم يقول: إنّها ربطة تضعها المرأة على رأسها. ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص158.
[444] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص190؛ فخر الدين الطريحي، المنتخب: ص337؛ محسن الأمين، لواعج الاشجان: ص199.
[445] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص194.
[446] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص245.
[447] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص120.
[448] الأمالي: ص91؛ ويُنظر: الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص45.
[449] هشام جعيط، الفتنة جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر: ص325.
[450] أمل محمّد خضر، دور نساء آل البيت السياسي والفكري في معركة الطف: ص2ـ3.
[451] جعفر البياتي، الأخلاق الحسينية: ص293؛ حسين الشاكري، العقيلة والفواطم: ص61.
[452] هناء سعدون جبّار، السيّدة زينب‘ودورها في أحداث عصرها: ص2.
[453] ابن سعد، الطبقات: ج4، ص314؛ العبيدلي، أخبار الزينبيّات: ص111؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص80؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص117؛ حسن محمّد قاسم، تاريخ مناقب ومآثر الستّ الطاهرة البتول زينب وأخبار الزينبيّات: ص30.
[454] ابن سعد، الطبقات: ج6، ص14.
[455] ابن سعد، الطبقات: ج4، ص312؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص150؛ المسعودي، مروج الذهب: ج2، ص5؛ محبّ الدين الطبري، ذخائر العقبى: ص177؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج1، ص505.
[456] ابن سعد، الطبقات: ج3، ص119؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص119.
[457] ابن سعد، الطبقات: ج4، ص312؛ محبّ الدين الطبري، ذخائر العقبى: ص177.
[458] ابن عنبة، عمدة الطالب: ص32.
[459] محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج3، ص485.
[460] العبيدلي، أخبار الزينبيّات: ص111.
[461] جعفر النقدي، زينب الكبرى‘وفاطمة بنت الحسين×: ص17.
[462] المصدر السابق؛ القطيفي، وفاة زينب الكبرى: ص2.
[463] حسن محمّد قاسم، تاريخ مناقب ومآثر الستّ الطاهرة البتول زينب وأخبار الزينبيّات: ص30؛ بنت الشاطئ، بطلة كربلاء زينب بنت الزهراء: ص27؛ عمر كحالة، أعلام النساء: ج4، ص91؛ محمّد كاظم القزويني، زينب الكبرى من المهد إلى اللحد: ص31.
[464] باقر شريف القرشي، السيّدة زينب‘رائدة الجهاد: ص37.
[465] الواقدي، المغازي: ج1، ص7؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2 ص113؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص453؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة: ص58؛ الطوسي، مصباح المتهجّد: ص790.
[466] الضحّاك، الآحاد والمثاني: ج5، ص354؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص6؛ المسعودي، التنبيه والإشراف: ص249؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج3، ص161؛ الهيثمي، مجمع الزوائد: ج9، ص211.
[467] أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص60؛ محمّد تقي التستري، قاموس الرجال: ج12، ص268؛ علي الأحمدي الميانجي، مواقف الشيعة: ج1، ص487.
[468] الدولابي، الذرية الطاهرة: ص166؛ ابن شهر آشوب، المناقب: ج3، ص90؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج5، ص469؛ هبة الدين الشهرستاني، السيّدة زينب في عاصمة أبيها: ص3.
[469] ابن عنبة، عمدة الطالب: ص37؛ جعفر النقدي، زينب الكبرى‘وفاطمة بنت الحسين×: ص103.
[470] المسعودي، مروج الذهب: ج2، ص74؛ محبّ الدين الطبري، ذخائر العقبى: ص231.
[471] ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج3، ص135.
[472] الطبقات: ج6، ص314؛ ويُنظر: سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص249؛ ابن عنبة، عمدة الطالب: ص38.
[473] أعلام الورى: ج1، ص396.
[474] تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: ج2، ص317.
[475] تهذيب الأسماء: ج1، ص264.
[476] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص359؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص92؛ ابن عنبة، عمدة الطالب: ص37.
[477] محمّد كاظم القزويني، زينب الكبرى من المهد إلى اللحد: ص54.
[478] قرية من قرى خيبر، وارضها خصبة، ذات أودية ومياه وعيون ومزارع ونخل كثير، وهي من اعمال المدينة، بينها وبين المدينة يومان، وبينها وبين خيبر أقلّ من مرحلة، وخيبر ناحية على ثمانية فراسخ من المدينة لِمَن أراد الشام، وفدك موقعها متميّز من خلال الطريق التجاري الذي يمرّ بالقرب منها، وسكّانها من اليهود الذين سكنوها بعد هجرتهم من بلاد الشام، وبعد معركة خيبر سنة 6هـ/627م أجلي عنها أهلها، فصارت ملكاً خالصاً للنبي’ فأنحلها ابنته فاطمة‘، قبل موته بأربع سنين، وقيل: إنّ خراجها سنوياً ثلاثمائة ألف دينار. تفاصيل أوسع عن فدك يُنظر: سامي جودة بعيد، فدك حتى نهاية العصر العباسي: ص13ـ197.
[479] البلاذري، فتوح البلدان: ج1، ص35؛ الجوهري، السقيفة وفدك: ص110؛ الشيخ المفيد، حديث نحن معاشر الأنبياء: ص27؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص238؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج16، ص219؛ العلّامة الحلّي، نهج الحقّ وكشف الصدق: ص269؛ السمهودي، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى: ج3، ص157ـ158؛ محمّد بيومي، السيّدة فاطمة الزهراء: ص138ـ146؛ عبدالله الناصر، محنة فاطمة بعد وفاة رسول الله’: ص65ـ85.
[480] أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص60؛ محمّد تقي التستري، قاموس الرجال: ج12، ص268؛ علي الأحمدي الميانجي، مواقف الشيعة: ج1، ص487.
[481] علي إبراهيم حسن، نساء لهنَّ في التاريخ الإسلامي نصيب: ج1، ص49.
[482] عبد الله المامقاني، تنقيح المقال: ص79.
[483] العبيدلي، أخبار الزينبيّات: ص122.
[484] جعفر النقدي، زينب الكبرى‘وفاطمة بنت الحسين×: ص122؛ بنت الشاطئ، السيّدة زينب: ص155.
[485] إنّ تحديد مكان دفن السيّدة زينب‘ ليس هو موضوع دراستنا، وعليه سنحيل القارئ إلى مَن تناول هذا الموضوع بحثاً ودراسةً. يُنظر: هناء سعدون العبودي، السيّدة زينب‘ودورها في أحداث عصرها: ص99ـ115.
[486] هناء سعدون العبودي، السيّدة زينب‘ ودورها في أحداث عصرها: ص57.
[487] يُنظر: ملحق رقم(1): ص465.
[488] الراوندي، منهاج البراعة: ج1، ص8؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج1، ص45؛ خنساء مهدي حمود، خطب نساء أهل البيت^ بعد واقعة الطفّ مدّة السبي ـ دراسة اسلوبية: ص2.
[489] الخفر: شدّة الحياء، والمرأة الخَفِرَة: التي سترت وجهها. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج4، ص253.
[490] إرتدّت الأنفس، أي لم تردّ جواباً. فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج3، ص49.
[491] أي هدأت من صوت أو حركة. الفراهيدي، العين: ج4، ص79.
[492] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص222؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص45؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص192؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص195. أمّا ابن طيفور فقد ذكر هذه الخطبة بإسم أم كلثوم، وهنا أستخدم كنية السيّدة زينب بدلاً من اسمها. يُنظر: بلاغات النساء: ص37.
[493] الختل: الخداع والمراوغة. ابن منظور، لسان العرب: ج11، ص199؛ الزبيدي، تاج العروس: ج14، ص191.
[494] الغدر: الخيانة ونقض العهد. يُنظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج2، ص18.
[495] رقأت: رقأ الدمع: سكن وأنقطع أو جفّ. الفراهيدي، العين: ج5، ص211؛ الجوهري، الصحاح: ج1، ص53.
[496] الرنّة: الصيحة الحزينة، الرنين: الصيحة عند البكاء بحزن. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج8، ص254.
[497] أنكاثا: أي تعقدون الإيمان، ثمّ تقومون بنقضه. يُنظر: محمّد حسين الطبطبائي، الميزان في تفسير القرآن: ج12، ص336.
[498] الخديعة والغدر، أي إعطاء العهد بالإيمان ثمّ الخداع والغدر. يُنظر: الكليني، الكافي: ج1، ص292؛ سعد أبو حبيب، القاموس الفقهي: ص129.
[499] الشدّة، والطعام الماسخ، ويُقال لِمَن يقصر كلامه ويمدح نفسه ولا خير عنده، ويقال: صلفت المرأة عند زوجها، أي لم تحظ عنده، والصلف: التكلّم بما يكرهه صاحبه، وتستعمل في الرجل والمرأة. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج7، ص129.
[500] التلطّخ بالعيب، ومَن به من نطفة، أي: تلطخ بالعيب والفساد، وتقول: فلان لزمته النطافة، وبعدت منه النظافة. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج7، ص436؛ الجوهري، الصحاح: ص1434؛ الزمخشري، أساس البلاغة: ص967.
[501] شدّة البغض والتنكّر، شنفه أي: أبغضه، والشنوف، الغيور الذي لا يفتر طرفهُ عن النظر من شدّة الغيرة والحذر. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج6، ص267؛ الجوهري، الصحاح: ج4، ص1383.
[502] الودّ واللطف الشديد، ورجل ملق: يعطي بلسانه، وليس بقلبه. الفراهيدي، العين: ج5، ص174.
[503] وهي العصر باليد، ورجل غَمَزٌ أَي ضعيف، وتعني أيضاً: رذال المال. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج4، ص386؛ الجوهري، الصحاح: ج3، ص889؛ ابن منظور، لسان العرب: ج5، ص389ـ390.
[504] المكان الذي تتراكم فيه أرواث الحيوانات وبولها، وتختلط مع التراب في المرابض، أي: حقول الحيوانات. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج13، ص158.
[505] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص30.
[506] ابن سعد، الطبقات: ج6، ص25؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص229؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص257؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص213؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص325.
[507] أمل محمّد خضر، دور نساء آل البيت السياسي والفكري في معركة الطف: ص256ـ260.
[508] النحل: آية92.
[509] الطبري، جامع البيان: ج14، ص198؛ الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ج6، ص38؛ البغوي، معالم التنزيل في تفسير القرآن: ج3، ص82؛ الطبرسي، مجمع البيان: ج6، ص194؛ الزمخشري، الكشاف: ج14، ص582.
[510] حسين أبو سعيدة، هكذا أنت يا بطلة كربلاء فكر جهادي انقدح من مدرسة عاشوراء ـ دراسة وتحليل: ص63.
[511] حسن موسى الصفّار، المرأة العظيمة قراءة في حياة السيّدة زينب: ص186.
[512] المنقري، واقعة صفّين: ص499ـ504؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص107.
[513] يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص278ـ325؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص34ـ52؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسن: ج2، ص73.
[514] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص30.
[515] وهو البكاء بصوت شديد مرتفع، طويل وممدود. يُنظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج5، ص27.
[516] التوبة: آية82.
[517] المعارج: آية4.
[518] يُقال ذهب بها، أي: أستصحبها، والذهاب: هو السير. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص393.
[519] وهو كلّ شيء يُلزَم منه عيب، أو كلّ ما يُعيَّر به الأنسان من قول أو فعل. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج6، ص251.
[520] شنر العيب والعار، والأمر المشهور بالشنعة، ورجل شنير: إذا كان كثير الشرّ والعيوب. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج6، ص251؛ الجوهري، الصحاح: ج2، ص407.
[521] هو غالباً ما يكون غسل الشيء المكروه النجس. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج7، ص153.
[522] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص30.
[523] الملجأ والحصن الآمن، الذي يحتمي الأنسان به في المصائب والشدائد. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج8، ص199.
[524] المؤمنون من الأبرار. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج6، ص2520.
[525] الملجأ والمُفزع لقومه فزعاً، وفلان مفزع النّاس: اذا داهمهم أمر فزعوا إليه. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج3، ص1358.
[526] مصيبة الدهر الشديدة تنزل بالنّاس. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج7، ص367.
[527] زعيم القوم والمتكلّم عنهم وخطيبهم، والذين يرجعون إلى رأيه. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج6، ص1231.
[528] وهو دون الدقّ، ويُقال للثوب البالي: سحق. يُنظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج3، ص139.
[529] وهو الخسران والضلال والهلاك. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج8، ص110؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص226.
[530] بفتح أوله وإسكان ثانيه وبعده قاف وهاء، البيعة، الصفقة على إيجاب البيع وعلى المبايعة والطاعة. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج2، ص265.
[531] أي نزّله وهيّئه ومكّن له فيه. يُنظر: الرازي، مختار الصحاح: ص42.
[532] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص30.
[533] وهو العذاب الشديد، الويلة، الفضيحة والبلية، واذا قيل: وويلتاه، أي: وفضيحتاه. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج8، ص366.
[534] وهي تقطيع الشيء وتشقيقه، وتقطيع اللحم. يُنظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج3، ص442.
[535] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص30.
[536] الزبيدي، تاج العروس: ج5، ص378.
[537] السرخسي، المبسوط: ج3، ص288؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص157.
[538] وهي عند العرب، كلّ خطّة مشهورة. يُنظر: الزبيدي، تاج العروس: ج11، ص278.
[539] وهي الداهية. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج 1، ص169.
[540] وهي مائلة الحنك. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص457.
[541] وهي الجاهلة. يُنظر: بن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج2، ص26.
[542] شوهاء: القبيح. الميداني، مجمع الأمثال: ج1، ص342.
[543] طلاع الأرض، تسيل الطلاع، أي ملء الأرض، وطلاع كلّ شيء ملؤه. يُنظر: الزبيدي، تاج العروس: ج1، ص98.
[544] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص30.
[545] خنساء مهدي حمود، خطب نساء أهل البيت^: ص6.
[546] السيّد ابن طاووس، الملهوف، ص١٩٢ ـ ١٩٣.
[547] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص413؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج16، ص141؛ ابن حجر الهيثمي، الصواعق المحرقة: ص294.
[548] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص344.
[549] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص425؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص201.
[550] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص424؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص442.
[551] المسعودي، إثبات الوصية: ص168؛ البيهقي، المحاسن والمساوئ: ص63؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص90؛ محبّ الدين الطبري، دلائل الإمامة: ص178؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص201؛ ابن حجر الهيثمي، الصواعق المحرقة: ص294.
[552] قيل هو ما أُذِيب من النحاس والرصاص وأشباههما، وقيل: هو القح والصديد، وقيل: هو دردي الزيت يشوي الوجوه، والاهمال والتمهّل، الإنظار. يُنظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص53؛ عبد القادر البغدادي، خزانة الأدب: ج4، ص484.
[553] أي دفعه من خلفه، وحفزه عن الأمر، أي أعجله وأزعجه. يُنظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج2، ص173.
[554] وهو الاسرع والتعجيل. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج6، ص2520.
[555] تفوت وتفاوت، أي عدم السبق عليه، وقيل الفوت هو الموت. الفراهيدي، العين: ج8، ص137.
[556] وهو الطلب بدم القتيل، أي قتل القاتل. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج8، ص236.
[557] الكليني، الكافي: ج4، ص576؛ الطوسي، مصباح المتهجّد: ص720؛ العلّامة الحلّي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب: ج2، ص892.
[558] النحل: آية1.
[559] الثعالبي، الجواهر الحسان: ج3، ص410.
[560] الطبري، جامع البيان: ج17، ص162.
[561] الثعالبي، الجواهر الحسان: ج3، ص410؛ السيوطي، تفسير الجلالين: ج1، ص345.
[562] ص: آية88.
[563] الطبري، جامع البيان: ج21، ص243؛ ابن أبي طالب المالكي، الهداية إلى بلوغ النهاية: ج10، ص6291؛ السمعاني، التفسير: ج4، ص456.
[564] وهو لباس للنساء يوضع على الرأس، وقد خِيطت مقدّمته. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج2، ص283.
[565] المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص115.
[566] عن وصية الإمام الحسين بن علي÷ لأخته السيّدة زينب في عشيّة العاشر من المحرّم. يُنظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص244؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص319؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص94؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم: ج2، ص75؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص338.
[567] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص349؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص222؛ الطبرسي، أعلام الورى: ص251؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص70؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص162.
[568] أمل محمّد خضر، خطب نساء آل البيت: ص100.
[569] هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه ـ دراسة في كتاب المساكين للرافعي: ص60.
[570] ابن سعد، الطبقات: ج8، ص473؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ص41؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص349.
[571] ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ص41؛ عباس القمّي، نفس المهموم: ص4.
[572] جعفر النقدي، زينب الكبرى‘وفاطمة بنت الحسين×: ص5؛ محمّد الحسّون، أعلام النساء المؤمنات: ص577.
[573] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص18؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين: ص24ـ25؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص362؛ جعفر النقدي، زينب الكبرى‘وفاطمة بنت الحسين×: ص6.
[574] الكليني، الكافي: ج1، ص303؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج4، ص172.
[575] أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبين: ص180؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج1، ص172؛ ابن عنبة، عمدة الطالب: ص84؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة في معرفة أحوال الأئمّة: ص54.
[576] أسماء بن خارجة بن حصين بن حذيفة بن بدر الفزاري، روى عن جماعة من أصحاب الرسول’، تُوفّي سنة 65هـ/684م وهو ابن ثمانين سنة. يُنظر: البخاري، التاريخ الكبير: ج2، ص55؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ج2، ص325؛ ابن حبان، الثقات: ج4، ص59؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج9، ص51؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج4 ص505.
[577] وهي خولة بنت منظور بن زبان بن سيار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن سمى بن مازن بن فزارة بن ذبيان، وكانت تحت محمّد بن طلحة بن عبيد الله، فقُتِل عنها يوم الجمل ولها منه أولاد، فتزوّجها الحسن بن علي بن أبي طالب. يُنظر: الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص20؛ ابن حبان، الثقات: ج2، ص311؛ ابن شهر آشوب، المناقب: ج3، ص192؛ ابن عنبة، عمدة الطالب: ص98.
[578] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص25؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص86؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص365.
[579] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص278؛ جعفر النقدي، زينب الكبرى‘وفاطمة بنت الحسين×: ص52؛ محمّد الحسّون، أعلام النساء المؤمنات: ص591.
[580] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص324؛ جعفر النقدي، زينب الكبرى‘وفاطمة بنت الحسين×: ص59ـ60.
[581] ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ص751؛ عبد الله المامقاني، تنقيح المقال: ص177.
[582] أشارت بعض الروايات إلى أنّها قد تزوّجت فيما بعد من عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفّان، وأنجبت منه محمّد الأصغر والقاسم ورقية. ولُقِب محمّد بالديباج؛ لحسنه وجماله، وقد سجنه الخليفة العباسي أبوجعفر المنصور(136ـ158هـ/753ـ774م)، مع أخيه لأمّه المثنى بن الحسن وأخوته، وفيما بعد قتلهم المنصور جميعاً سنة 145هـ /762م. ابن سعد، الطبقات: ج5، ص319؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص180؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ص83؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص293، 349.
[583] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص352.
[584] عمر كحالة، أعلام النساء: ج4، ص47؛ ياسين العمري، مهذّب الروضة الفيحاء في تواريخ النساء: ص199؛ محمّد الحسّون، أعلام النساء المؤمنات: ص597.
[585] وهو سوار أو حجل: الذي تلبسه المرأة، وتخلخلت المرأة: لبست الخلخال. يُنظر: ابن السكّيت، ترتيب إصلاح المنطق: ص149، 205؛ الزمخشري، أساس البلاغة: ص155؛ ابن منظور، لسان العرب: ج11، ص221.
[586] الصدوق، الأمالي: ص228.
[587] والجمع ذحول، أي الحقد والأعداء، يُقال طلب بذحله، أي بثأره. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج4، ص1701.
[588] وهي جمع ترة، ومعناها أخذ الثأر. يُنظر: القيرواني، زهر الآداب: ج4، ص1095.
[589] أي لا أكذب، أو أختلقه، أو ألبس الكلام. يُنظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص373.
[590] أي الإعثار والسقوط والهلاك. يُنظر: فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج4، ص56.
[591] وهي يُمن العمل، وقيل النقيبة: النفس، أو الطبيعة، أو الخليقة. يُنظر: الفراهيدي، العين ج5 ص180؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج5، ص102؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص768.
[592] وهي الطبيعة، وفلان لين العريكة، أي كان سَلٍساً. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج4، ص1599.
[593] الشُهرة من الانتشار والوضوح، والخبر المشهور سمّي بذلك لاشتهاره. يُنظر: أحمد عبد الرحمن عبد المنعم، معجم مصطلحات والألفاظ الفقهية: ج3، ص294.
[594] واحده: المذهب، وهو المعتقد. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص394.
[595] هي الملاومة، وهي أن تلوم رجلاّ ويلومك، ورجل لُوم، ملوم. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج5، ص1234.
[596] وهي الملامة، ويُقال: عذلنا فلاناً، اعتذل؛ أي لام نفسه. يُنظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج3، ص200.
[597] بالضم والكسر، التكبّر، والعجب والاعجاب بالنفس. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج4، ص1692.
[598] وهي موضع السرّ عند الرجل، والذين يأتمنهم على أمره: العيبة، وقيل أيضاً: العيبة هي الصدر النقي من الغلّ. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج 2، ص264.
[599] بالكسر وهو أصل الشجرة، وهو ما عظم من أصول الشجر. يُنظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص438.
[600] الحديد: آية22ـ23.
[601] وهو الخسران والضلال والهلاك. يُنظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص341.
[602] هو الأمر الشاقّ، وهو الضرر والفساد أيضاً. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج1، ص258.
[603] وهي الحجارة. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص179.
[604] الاثلب: تراب الحجارة، أي فُتاتُها. ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص241.
[605] وهو السكوت، وأكظم، أي أسكت. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص520.
[606] اقعى الرجل في جلوسه، أي تساند إلى ما ورائه. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج15، ص292.
[607] الحديد: الاية21.
[608] النور: آية40.
[609] انتضحت، نضح، أي رشه رشاً خفيفاً. يُنظر: الزبيدي، تاج العروس: ج4، ص233.
[610] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص195؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص94؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص315؛ كاشف الغطاء، الملحمة الكبرى لواقعة كربلاء: ص119.
[611] خنساء مهدي حمود، خطب نساء أهل البيت^: ص7.
[612] ابن عنبة، عمدة الطالب: ص32؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج3، ص484.
[613] وهي كلمة زجر للسكوت. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج3، ص345؛ ابن السكّيت، ترتيب إصلاح المنطق: ص229؛ الجوهري، الصحاح: ج6، ص2239.
[614] هو الخسران والضلال والهلاك. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج8، ص110؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص226.
[615] هو دون الدقّ، ويُقال للثوب البالي سحق. يُنظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج3، ص139.
[616] وجمعه دهوك، وهو الطحن والتقطيع والكسر. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج4، ص1586؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج2، ص307.
[617] المائدة: آية56.
[618] المجادلة: آية19.
[619] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص198؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص88؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص316.
[620] وهو الهلاك. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج8، ص222؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص99.
[621] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص198؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص88؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص316.
[622] المائدة: آية56.
[623] المجادلة: آية19.
[624] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص211؛ العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث: ج2، ص153؛ ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار: ص104؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص360؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص326؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج5، ص242؛ المزي، تهذيب الكمال: ج15، ص321.
[625] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص211؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج20، ص230.
[626] ابن داود، رجال: ص202؛ المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج3، ص163؛ محمّد تقي التستري، قاموس الرجال: ج11، ص31.
[627] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص135؛ محمّد بن اسماعيل المازندراني، منتهى المقال: ج4، ص384.
[628] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص361؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج9، ص121.
[629] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص361؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص41؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج20، ص230.
[630] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص211؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص326.
[631] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص211؛ خليفة بن خياط، الطبقات: ص449؛ ابن قتيبة، المعارف: ص215؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص147؛ المزي، تهذيب الكمال: ج15، ص321.
[632] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص211؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص147.
[633] ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج9، ص311.
[634] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص211.
[635] المصدر السابق.
[636] بضم أوله، وهـي مساحة واسعة، وتقع في أطراف الكوفة الغربية من جهة البادية، وكانت سوقاً تُباع فيها الإبل، ومناخاً للقبائل العربية القادمة إلى الكوفة للاستيطان فيها في وقت تأسيسها، وكانت قبيلتا بني أسد وبني تميم تطرحان في هذا المكان كناستهما، كما اتُّخِذت مكاناً لتجمّع القبائل العربية في وقت حوادث التوتّر. يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص199؛ المقدسي، أحسن التقاسيم: ص177؛ أبو عبيد البكري، معجم ما أستعجم: ج4، ص1136؛ صالح أحمد العلي، الكوفة وأهلها في صدر الإسلام: ص42.
[637] ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار: ص105؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص366؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج5، ص242.
[638] ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار: ص104؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص360.
[639] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص361؛ أحمد الخطيب، الوفيات: ص100.
[640] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص303.
[641] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص221.
[642] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص360.
[643] المصدر السابق: ص361؛ المزي، تهذيب الكمال: ج15، ص321؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج20، ص231؛ السيوطي، إسعاف المبطأ: ص78.
[644] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص409.
[645] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص303؛ المزي، تهذيب الكمال: ج35، ص41؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج12، ص305.
[646] تذكرة الخواص: ص409.
[647] سماطين: يقال: قام القوم حوله سماطين أي صفين، وكل صف من الرجال سماط. ابن منظور، لسان العرب: ج7، ص325.
[648] هو أبو فراس، أو أبو الاخطل، همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال، التميمي البصري، ولد في البصرة عام 20هـ/641م، ونشأ فيها، وتجول في البادية وتطبع بطباعها، فهـو سيد بادية بني تميم، وكان يقول الشعر في كلّ شيء، وأمه ليلى بنت حابس أخت الصحابي الاقرع بن حابس، وزوجته النوار انجبت له اربعة أبناء وبنتا واحدة، عاش الشاعر متنقلاً بين الخلفاء والامراء والولاة مادحاً لهم، ولقبه الفرزدق لغلظه وقصره. يُنظر: ديوان الفرزدق ص511ـ514؛ ابن هشام، السيرة النبوية: ج1، ص40؛ ابن قتيبة، الشعر والشعراء: ج1، ص381؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج21، ص108؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج7، ص212؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج27، ص224.
[649] هو موضع بضم أوله وإسكان ثانيه، سُمّيت عسفان لتعسّف السيل فيها، وهي لبني المصطلق، تبعد عن مكّة مرحلتين. يُنظر: المُهلّبي، المسالك والممالك: ص36؛ أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج3، ص942؛ الزمخشري، الجبال والأمكنة: ص230؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص121؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج2، ص940.
[650] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص416؛ اليافعي، مرأة الجنان: ج1، ص189؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب: ج1، ص144.
[651] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص413.
[652] ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص212؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص119؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص117؛ ابن عبد البر، التمهيد: ج9، ص157.
[653] قُتل صبراً، أمسك حياته تكلّفاً حتى مات. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج2، ص702.
[654] هو الخسران والضلال والهلاك. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج8، ص110؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص226.
[655] هو الخيط الذي يُشدّ في الإبرة، أو في الخشاش، ثمّ يُشدّ في طرفه المقود، أي بمعنى أنّهم تحت قيادته. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص272؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج6، ص81.
[656] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص197؛ النعمان المغربي، شرح الأخبار: ج2، ص499؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص199ـ200.
[657] شيّد سعد بن أبي وقّاص هذا القصر عام 16هـ/637م بعد معركة القادسيّة، وفتح العراق وسقوط الدولة الساسانية، وكان يُعرف بقصر سعد، قصر الامارة، دار الامارة، وقصر خبال، ولمّا عرف عمر بن الخطاب(13ـ23هـ/634ـ643م) تشييد سعد لهذا القصر كتب إليه: "بلغني أنّك اتّخذت قصراً، جعلته حصناً يُسمّى قصر سعد، بينك وبين النّاس باب، فليس بقصر، ولكنه قصر الخبال، انزل منه ممّا يلي بيوت الأموال واغلقه، وأن لا تجعل على القصر باباً يمنع النّاس من دخوله "، وقد اتُّخذ هذا القصر مقرّاً لولاة الكوفة في العصور الإسلامية المتعاقبة، باستثناء مدّة خلافة الإمام علي بن أبي طالب×، حيث أدار شؤون الدولة من المسجد الأعظم، وقد هُدّم هذا القصر بأمر من الحاكم الأموي عبد الملك بن مروان(65ـ86هـ/ 684ـ705م)؛ لتشاؤمه منه، ويبدو أنّه بمرور الزمن أخذ بالاندراس. البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص212؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص150؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص116؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص529؛ ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الامصار: ص214؛ البراقي، تاريخ الكوفة: ص107.
[658] وهو الحديث الذي كثر فيه الكلام. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج3، ص177.
[659] هو المرقد. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج2، ص476.
[660] هو العلو وفوت الأصحاب، يفلج الرجل أصحابه: يعلوهم ويفوتهم. يُنظر: ابن سلّام، غريب الحديث: ج3، ص239؛ ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص347.
[661] هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي، ويُكّنى أبا سعيد، ولد أيّام بدر، وقيل: قبل الهجرة بسنتين، وتُوفّي النبي وعمره اثنتا عشرة سنة، له صحبة هو وأبوه، رُوي عن النبي وأبي بكر وعمر والإمام علي× وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه ابنه جعفر وآخرون، بنى له داراً كبيرة إلى جانب المسجد في الكوفة، وكانت داره مأوى لأعداء آل البيت، تولّى الكوفة لزياد ابن أبيه، ومن ثمّ لابنه عبيد الله، وتُوفّي سنة 85هـ/704م. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج6، ص24؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص1173؛ السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة: ج2، ص319؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص417؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج4، ص510.
[662] هم القباح من النّاس، ويتّصفون بالغضب. يُنظر: الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج1، ص294.
[663] هو الذي خطّه الشيب، أي خالطه، ورأيت به هيبة وتبجيلاً وسنّاً، والكهل من الرجال ما زاد عن اربع وثلاثين إلى إحدى وخمسين سنة. الفراهيدي، العين ج3، ص378، و ج6 ص134؛ الزبيدي، تاج العروس: ج15، ص670؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج5، ص467.
[664] هو التفريع بين القوم تفريعاً، أي تفريع النسل. يُنظر: الزبيدي، تاج العروس: ج11، ص342.
[665] أي اقتلعه. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص126.
[666] هو كلام مقفّى، وله فواصل كقوافي الشعر من غير وزن. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج1، ص214.
[667] وتعني: لا بدّ، لا شكّ. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج6، ص119.
[668] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص349؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص222؛ الطبرسي، أعلام الورى: ص251؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص70. وعند الشيخ المفيد "قالت السيّدة زينب‘: ما للمرأة والسجاعة، إنّ لي عن السجاعة لشغلاً، لكن صدري نفث بما قلت". الإرشاد: ج2، ص162.
[669] الأمالي: ص139.
[670] الزمر: آية41.
[671] آل عمران: آية145.
[672] الطبرسي، أعلام الورى: ص249؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص47ـ48؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص201ـ202؛ باقر شريف القرشي، السيّدة زينب‘: ص26. وبألفاظ أخرى، يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص350؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص26؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص82.
[673] الصدوق، الأمالي: ص229؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص190؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص145.
[674] أنساب الأشراف: ج3، ص226.
[675] الكامل: ج4، ص84.
[676] اللهوف: ص95.
[677] ابن خياط، تاريخ: ص145؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص149؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص303؛ عبد الله المامقاني، تنقيح المقال في علم الرجال: ج3، ص78.
[678] تذكرة الخواص: ص233.
[679] تفاصيل اوسع عن نشوء حركة التوابين يُنظر: خالد راسم امير، حركة التوابين 61ـ64هـ/ 680ـ684م دراسة تاريخية: ص124ـ162.
[680] تفاصيل اوسع عن حركة المختار الثقفي وتتبعه لقتلة الإمام الحسين×، يُنظر: رغداء حسين محمد، حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي وابعادها السياسية والفكرية ص57ـ101.
[681] الطبقات: ج5، ص212.
[682] تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص367.
[683] المنتظم: ج5، ص345.
[684] تذكرة الخواص: ص327.
[685] ابن حنبل، المسند: ج3، ص261؛ البخاري: صحيح: ج4، ص216؛ ابن شهر آشوب، مناقب: ج3، ص230؛ ابن البطريق، عمدة عيون صحاح الأخبار: ص401.
[686] محبّ الدين الطبري، ذخائر العقبى: ص127.
[687] صحيح: ج15، ص430.
[688] العيني، عمدة القاري: ج16، ص241.
[689] الشجري، الأمالي الخميسية: ج1، ص192.
[690] هو صحابي وشيخ كبير، شهد غزوة مؤته، وقيل: عُمِي بعد وفاة النبي، ثمّ ردّ الله تعالى إليه بصره، وتُوفّي عام 66هـ/686م، وقيل: عام 68هـ/687م في الكوفة. يُنظر: الذهبي، تذكرة الحفاظ: ج1، ص532.
[691] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص326.
[692] الدينوري، الأخبار الطوال: ص231؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص349؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص296؛ أبو العرب، المحن: ص137.
[693] المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص116.
[694] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص327.
[695] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص206ـ207؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص351.
[696] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص207؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص96.
[697] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص207؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2 ص59.
[698] عبد الرحمن بن مخنف الازدي، يعد من القادة الشجعان، وانتهت إليه رئاسة أزد شنؤة وازد عمان، وكان مع المهلب ابن أبي صفرة، في قتال الازارقة، وقتل في كازرون في اقليم فارس. يُنظر: الزركلي، الأعلام: ج3، ص336.
[699] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص351.
[700] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص210؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص351.
[701] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص60.
[702] هو عمرو بن الحجاج بن عبد الله بن عبد العزيز بن كعب بن سلمة بن مالك بن سلمة بن مازن ابن ربيعة بن زيد الزبيدي المذحجي، عاش حتى شارك في مقتل الإمام الحسين، وكانت نهايته مجهولة. يُنظر: الطبري، تاريخ: ج4، ص525؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ج2، ص412؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص236؛ ابن حجر، الاصابة ج5، ص111.
[703] هو شبث بن ربعي بن حصين بن عثيم بن ربيعة بن زيد بن رباح بن يربوع بن حنظلة من بني تميم، وكنيته أبو عبد القدوس، كان مؤذن سجاح التي أدعت النبوة، ثمّ أسلم، وقد أعان على عثمان بن عفّان، وصحب علياً، وكان معه في صفين على بني عمرو، وفي النهروان على ميمنة علي، وصار خارجياً ثمّ تراجع عن ذلك، وكان رسولاً بين علي ومعاوية، وتولى شرطة الكوفة لابن زياد، وكان على الرجالة في واقعة الطفّ، ويبدو انه كان كارهاً لقتال الحسين، وتُوفّي عام 70هـ. يُنظر: المنقري، واقعة صفّين: ص212؛ ابن سعد، الطبقات: ج8، ص335.
[704] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص207؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك:ج4 ص351؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص124؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص60.
[705] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص126؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص60؛ علي الأحمدي الميانجي، مواقف الشيعة: ج2، ص196.
[706] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص209.
[707] المصدر السابق.
[708] جندب بن عبد الله الازدي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[709] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص125.
[710] المصدر السابق: ص126.
[711] المصدر السابق؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2 ص61ـ62.
[712] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص126؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص122.
[713] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص126.
[714] سفيان بن يزيد الأزدي، وهو من أزد شنوءة، روى عن النبي، وروى عنه محمّد بن سيرين، وشارك في واقعة الجبانة في ميمنة إبراهيم بن مالك الأشتر. يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص355؛ ابن حبان، الثقات: ج4، ص320؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص632.
[715] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص126.
[716] هو أبوعبد الله اليشكري القيسي، من وُلد قيس بن ثعلبة الضبعي البصري، من كبار التابعين، يروي عن الإمام علي بن أبي طالب×، وعمر بن الخطاب، وأبي ذرّ الغفاري، وعمار بن ياسر، والحسن البصري، وابن سيرين، وآخرين. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج7، ص131؛ السخاوي، التحفة اللطيفة: ج2، ص388.
[717] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص327.
[718] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج37، ص415؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص265؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص329؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج12، ص265؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص314؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج2، ص308.
[719] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص357؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص88؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص94؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص472؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص227.
[720] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص202؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص118.
[721] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص205.
[722] المصدر السابق.
[723] ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص224.
[724] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص270ـ271؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص442؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص205؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج18ص297؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6 ص29.
[725] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص205.
[726] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص271؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص205؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص29.
[727] محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص38؛ علي رحيم أبو الهيل، السياسة الأموية المضادة للإمام علي: ص107.
[728] الفراهيدي، العين: ج5، ص227؛ ابن منظور، لسان العرب: ج5، ص222.
[729] القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: ص475؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج22، ص49؛ اليافعي، مرأة الجنان: ج1، ص109.
[730] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص329.
[731] تاريخ بغداد: ج13، ص326.
[732] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص349.
[733] المصدر السابق: ص351؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص117؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج18، ص445؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص83؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج8، ص3784؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج14، ص127.
[734] الكهف: آية9.
[735] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص118؛ الطبرسي، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص473؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج2، ص279.
[736]سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص329.
[737] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص208؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص351؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج18، ص445؛ عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص359؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج8، ص3784؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج14، ص127.
[738] ومن الاعمال التي أسسها واهتم بها معاوية بن أبي سفيان(41ـ60هـ /661ـ679م) خلال حكمه، البريد وانشاء المحطات اللازمة له، وزودت بكل الوسائل التي تحتاجها، وقد توزعت تلك المحطات في الطرق ما بين مركز الحكم في دمشق، ومراكز الولايات التابعة لدولة بني أميّة، وقسم الطريق إلى عدة مراحل، والمرحلة تساوي ستة أو سبعة فراسخ، والبريد على نوعين، الأول: البريد المستعجل، ويقوم بإيصال الاخبار بسرعة، من وإلى مركز الحكم، وكان غالباً ما ينشط في اوقات الحروب، والازمات التي تمر بها الدولة، والثاني: هـو البريد العادي المنظم، ويقوم بنقل مراسلات الدولة من المقر إلى الولايات وبالعكس. تفاصيل أوسع عن البريد وتطوره، يُنظر: خالد عبد الرزاق البريد في التاريخ: ص53؛ خولة عيسى محمّد صالح، نشأة البريد وتطوره في الدولة العربية الإسلامية حتى عام 334هـ: ص107؛ قيس حاتم هاني الجنابي، نشأة وتطور البريد في الدولة العربية الإسلامية حتى عام 86هـ: ص8؛ عبد صالح، البريد في العصور الإسلامية: ص7.
[739] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص216؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص298.
[740] لقد توصّل أحد الباحثين إلى أنّ المراسلات التي كانت تجري بين محمّد بن القاسم الثقفي في الدبيل، والحجاج بن يوسف الثقفي(75ـ95هـ/694ـ713م) في واسط؛ تستغرق ثلاثة أيّام، وبالرغم من أنّ المسافة بينهما تقدر 690 فرسخا، ما يعادل 3331 كم، أي أنّه يقطع 46 كم في الساعة، بينما المسافة بين الكوفة ودمشق، وعلى طريق البريد، وُجِدت من خلال استخدام خاصيةGps لتحديد المسافات ما يقرب 850 كم، فاذا قُسّمت على نفس السرعة، التي كان صاحب البريد يقطعها في تلك المدّة، فإنّها ستكون 18 ساعة. يُنظر: خولة عيسى صالح الفاضلي، نشأة البريد وتطوره في الدولة الإسلامية: ص109. وتشير الدراسات المعاصرة، بأنّ صاحب البريد يقطع خلال الساعة الواحدة 46 كم، مع ملاحظة أنّ الفَرَس بإمكانه أن يسير 40 ميل، 64 كم في الساعة. يُنظر: P. 116 Guiness book of records، وهذا يعني أنّ البريد حتى يصل إلى دمشق يحتاج إلى 18 ساعة، أي أقل من يوم واحد.
[741] ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص81.
[742] تذكرة الخواص: ص330.
[743] ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج2، ص215؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج6، ص313؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج5، ص175؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص527.
[744] البلاذري، أنساب الأشراف: ج4، ص304؛ ابن طيفور، بلاغات النساء: ص59؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص46؛ أبوهلال العسكري، الأوائل: ص143.
[745] الصدوق، الأمالي: ص229.
[746] البلاذري، أنساب الأشراف: ج11، ص33؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص260؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص331؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج6، ص225.
[747] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الصدوق، الأمالي: ص230؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص83؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص208.
[748] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص98.
[749] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص127؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص62.
[750] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص81؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص101.
[751] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص98.
[752] أبو خالد ذكوان، ويُقال: طهمان، وهو من موالي بني أميّة، وقد أعتقوه. ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص466.
[753] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص81.
[754] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص118؛ فخر الدين الطريحي، المنتخب: ص467.
[755] ويُذكر أنّ الإبل التي حُمِل عليها رأس الإمام الحسين× وأصحابه، وسبايا أهل بيته، لمّا نُحِرت لم يستطع أحد من أكل لحومها؛ لأنّها كانت أمرّ من الصبر. ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3 ص218؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص337؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص305.
[756] جعفر المهاجر، موكب الأحزان: ص20.
[757] ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص89.
[758] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص127.
[759] اُختُلِف في أسمه، بعضهم يسميّه: محفز، وهذا الذي نستخدمه في دراستنا، ويسميّه آخرون: محقن، كما يُسمّى: مجفر، ويُسمّى: محفر. يُنظر: الكلبي، الأنساب: ص28؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص260؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ص174؛ الطبرسي، أعلام الورى: ج1، ص473؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج6، ص2631؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص100.
[760] هـو محفز بن ثعلبة بن مرّة بن خالد بن عامر بن قنان بن عمرو بن قيس بن الحارث بن مالك بن عبيد بن خزيمة بن لؤي بن غالب بن فهر العائذي القرشي، وخزيمة يُدعون: عائذة قريش، نسبةً إلى أمّهم عائذة بنت الخميس بن قحافة بن خثعم، وبها يُعرفون، وروى عن محفز ولَدُه عبيد الله، وفد على يزيد بن معاوية. يُنظر: مصعب الزبيري، نسب قريش: ص438؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج11، ص34؛ الدارقطني، المؤتلف والمختلف: ج4، ص2139؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص96.
[761] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص216؛ ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص82؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج5، ص19.
[762] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص82؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج6، ص225.
[763] ويُسمّى عند بعض المؤرخين: زجر بن قيس الجعفي. يُنظر: ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص127؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ج2، ص831.
[764] زحر بن قيس بن مالك بن معاوية بن سعنة بن داء الجعفي الكوفي، وهو من صحابة الإمام علي ابن أبي طالب×، أنزله على المدائن ومعه اربعمائة من أهل العراق، وفي المدائن أخبر بضرب ابن ملجم الإمام علياً×، واستشهاده فيما بعد، ثمّ وصله كتاب الإمام الحسن بن علي× يطلب فيه أخذ البيعة له. يُنظر: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ص409؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج8، ص490؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج18، ص444؛ ابن الأثير، اللباب في تهذيب الأنساب: ج1، ص129؛ ابن داود الحلّي، رجال بن داود: ص96؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص520.
[765] أبو بردة بن عوف بن عبد نهم الأزدي، عراقي من التابعين، عثماني المذهب، وفد على يزيد بن معاوية. يُنظر: ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ص383؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج66، ص16؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج10، ص4330.
[766] طارق بن أبي ظبيان الأزدي، عراقي من التابعين، وفد على يزيد بن معاوية. يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج24، ص430.
[767] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص83؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ج2، ص831.
[768] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص127.
[769] الأخبار الطوال: ص260؛ ويُنظر: ابن العديم، بغية الطلب: ج6، ص2631.
[770] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الصدوق، الأمالي: ص230؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص83؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص208.
[771] مقتل الحسين×: ص208.
[772] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352.
[773] ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص83.
[774] هو عمرو بن الحجّاج بن عبد الله بن عبد العزيز بن كعب بن سلمة بن مالك بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن زيد الزبيدي المذحجي، وعاش حتى شارك في مقتل الإمام الحسين×، وكانت نهايته مجهولة، فعندما تابع المختار الثقفي قتلة الإمام الحسين×، خرج عمرو براحلته وأخذ طريق شراف وواقصة، ولم يُعرف له خبر، وكان ذلك سنة 66هـ/685م. يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص525؛ ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب: ص412.
[775] المنتخب: ص467.
[776] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص125ـ128؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص544؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص383ـ387؛ زهير بن علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف: ج2، ص73ـ77.
[777] البيروني، الآثار الباقية عن القرون الخالية: ص331؛ القزويني، عجائب المخلوقات: ص45.
[778] الإستقراء لغةً، يعني تتبع الجزئيات، للحصول على حكم كلي، واصطلاحاً، تتبع الامور وجمعها، وجمع خواصها. يُنظر: عبد الهادي الفضلي، خلاصة المنطق: ص67؛ مركز المجمع الفقهي، المصطلحات: ص276.
[779] دمشق، بكسر أوله وفتح ثانيه، والشين معجمة، وآخره قاف، وهي بلدة مشهورة بقصبة الشام وجنّة الأرض، لِحُسن عمارتها ونظارتها، وكثرة مياهها وفاكهتها، ونزاهة رقعتها، وسُمِّيت دمشق؛ لأنّ أهلها دمشقوا، أي: أسرعوا في بنائها. يُنظر: السيرافي، رحلة: ص110؛ إسحاق المنجم، آكام المرجان: ص57؛ المُهلّبي، المسالك والممالك: ص87؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص463؛ الحميري، الروض المعطار: ص237.
[780] الحيرة، بالكسر ثمّ السكون وراء مهملة، مدينة تبعد ثلاثة أميال عن الكوفة، أي ما يُعادل: 4 كيلو مترات و 828 مترا. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص328؛ محمّد علي جعفر التميمي، مدينة النجف: ص51.
[781] الأبيض، وهو من قصور الحيرة، وقيل: بناه هارون الرشيد(170ـ193هـ/786ـ 808م). ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1096.
[782] الحوشي، بالضمّ، رمل بالدهناء، وهي إحدى محطّات طريق البادية، بين الكوفة ودمشق، تقع بعد القصر الأبيض. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص219؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص437.
[783] الجمع، وهي مشعر المزدلفة، وفيه يُجمع بين صلاتَي المغرب والعشاء، ومنها يُؤخذ حصى الجمرات، وسُمِّي بالجمع لاجتماع النّاس به. ويبدو أنّ الجمع موضع آخر غير ما ذكر، بل هو إحدى محطّات طريق البادية، بين الكوفة ودمشق. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص163؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص346؛ الحميري، الروض المعطار: ص171.
[784] الخطي، بالضمّ والقصر، وهو موضع بين الكوفة والشام. ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص473.
[785] الجُبّة، بالضمّ والتشديد، وهي قرية قرب هيت، عبارة عن جزيرة في الفرات. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص108؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص322.
[786] الساعدة، تقع في جبال أبلا، وهي إحدى محطّات الطريق، بين الكوفة ودمشق. ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص99؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص171؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج2، ص189.
[787] البقيعة، البقاع جمع بقعة، وهو موضع يُقال له: بقاع كلب واسع، قريب من دمشق، ويقع بين بعلبك وحمص ودمشق. ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص225.
[788] الأعناك، بالنون والكاف، بلدة من نواحي حوران، من أعمال دمشق، يعمل فيها بسط وأكسية جيّدة. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص222؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص96؛ محمّد كرد علي، خطط الشام: ج4، ص200.
[789] أذرعات، بالفتح ثمّ السكون ثمّ هاء وعين مهملة والف وتاء، بلد في طرف الشام، وتجاور أرض البقاع المنسوبة إلى أذرع. ولمّا قدم عمر بن الخطاب إلى الشام سنة 17هـ/638م، تلقّاه أبو عبيدة الجرّاح فيها. الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص158؛ أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج1، ص131؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص130؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص47؛ الحميري، الروض المعطار: ص19.
[790] منزل، لم نعثر على تعريف له في المصادر التي بين أيدينا.
[791] ابن خرداذبه، المسالك والممالك: ص99. ويُنظر: خارطة رقم (4): ص472.
[792] هيت، بكسر أوله، والتاء المعجمة باثنتين من فوق، مدينة تقع في غرب العراق، وعلى شاطئ الفرات، والهيت الهوة، وسُمّيت هيتاً؛ لأنّها في هفوة، وقيل: إن الهيت الموضع الغامض المنخفض. أبو عبيد البكري، معجم ما أستعجم: ج4، ص1357؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص420؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ص281؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1468؛ الحميري، الروض المعطار: ص597.
[793] عانة، وجمعها عانات، والعانة الجماعة من حمر الوحش، وتقع بين الرقّة وهيت، ويطوف بها خليج من نهر الفرات، كثيرة الأشجار والثمار والكروم، ولها قلعة حصينة، وتُعدّ في أعمال الجزيرة الفراتية، ومن طساسيج الأنبار. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص72؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ص418؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج2، ص912.
[794] آلوسة، بضم اللام وسكون الواو والسين مهملة، بلد على الفرات، قرب عانة، وقيل: فيه آلوس بغير مدّ. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص56؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص6.
[795] قرقيسيا، بفتح أوله وسكون ثانيه بعده قاف أخرى مكسورة وياء وسين مهملة وياء أخرى، من كور ديار ربيعة، وبين الحيرة والشام، وهي نزهه ذات نعمة، وسوادها دائم الخضرة. مؤلِّف مجهول، حدود العالم من المشرق إلى المغرب: ص162؛ المُهلّبي، المسالك والممالك: ص112؛ أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج2، ص1066.
[796] ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص217؛ جعفر المهاجر، موكب الأحزان: ص43. والرقّة، بفتح أوله وثانيه وتشديده، وجمعها أرقّاء، وأصله: كلّ أرض إلى جنب الوادي، ينبسط عليها الماء أيّام المدّ، ثمّ ينحسر عنها وتكون مكرمة للنبات، والرقّة: الأرض ليّنة التراب، وتقع على الضفّة اليسرى لنهر الفرات، فهي على شاطئ الفرات الشمالي، في السهل المحصور بين الفرات ورافده البليخ في الجزيرة الفراتية، وسميت بالرقّة البيضاء؛ وذلك لجمالها، وغلبة اللون الأبيض في بناء منازلها، عند فتح العرب المسلمين لها، في سنة 17هـ/638م أو سنة 18هـ/639م، في عهد عمر بن الخطاب(13ـ23هـ/634ـ643م). أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج2، ص666؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص177؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص58؛ ابن شداد، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: ج1 ص123؛ الحميري، الروض المعطار: ص270؛ نادية محسن عزيز، الدور الحضاري لمدينة الرقّة في العصر العباسي (132ـ380هـ/749ـ993م): ص9ـ16.
[797] حمص، بالكسر ثمّ السكون والصاد مهملة، بلد مشهور قديم كبير، مسوّر في طرفه القبلي، قلعة حصينة على تلّ عال كبير، وهي بين دمشق وحلب في نصف الطريق، بناها رجل يُقال له حمص ابن المهر بن جون بن مكنس، وقيل: حمص بن مكنس العمالقي. السيرافي، الرحلة: ص100؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص302؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ص184؛ شهاب الدين العمري، مسالك الأبصار: ج3، ص531.
[798] ابن خرداذبه، المسالك والممالك: ص98. ويُنظر: خارطة رقم (5): ص473.
[799] شاهي، وتُدعى شوشي أيضاً، وهي في سواد الكوفة، وتبعد عنها خمسة فراسخ؛ أي: 24كم، وهي بالقرب من مقام زيد بن علي بن الحسين÷، قريب من قرية في ذي الكفل، ويعدّها ياقوت موضعا قرب القادسيّة. ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص158؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج9، ص286؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج9، ص31؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص316.
[800] القناطر، موضع يقع بين شاهي واليعقوبية. ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص183.
[801] اليعقوبية، وهي إحدى محطّات الطريق بين موضع بغداد والكوفة، وتبعد عن الكوفة 35 ميل، أي: 56 كم. ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص183.
[802] سوق أسد،
وهي سوق في الكوفة، منسوبة إلى أسد بن عبد الله القسري البجلي اليماني
(ت120هـ/737م)، أخو خالد بن عبد الله القسري (ت 126هـ/743م)، والي العراق الأموي،
ومن سوق أسد إلى اليعقوبية أربعة أميال؛ أي: ما يعادل 6 كم، ومن قصر ابن هبيرة إلى
سوق أسد سبعة فراسخ، أي: ما يعادل 33 كم. ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص183؛ ابن
خرداذبة، المسالك والممالك: ص185؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص283.
[803] قصر ابن هبيرة، مدينة قريبة من عمود نهر الفرات، وليس بين موضع بغداد والكوفة مدينة أكبر منها، ويطلّ عليها عن يمين وشمال الفرات أنهار متفرّقة ليست كبيرة، وكربلاء محاذية لقصر ابن هبيرة من الغرب في البرية، وهو يُنسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري(ت 132هـ/749م)، ويبعد القصر عن عمود الفرات فرسخين، أي: تسعة كم، ولمّا تولّى أبو العباس السفاح(132ـ136هـ/749ـ754م) الخلافة العباسية، نزله وأتمّ تسقيف ما قصر فيه، وزاد في بنائه، وسماه الهاشمية، ولم ينزل أبو جعفر المنصور (136ـ158هـ/754ـ775م) فيه، بل بنى قصراً بالقرب منه، ونزله قبل أن يتمّ بناء بغداد، ويبعد قصر ابن هبيرة عن سوق أسد سبعة فراسخ؛ أي 33 كم، وفي وقتنا الحاضر يقع قصر ابن هبيرة شرق قضاء المسيّب ضمن محافظة بابل بعشرة كم. ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص236؛ أبو الفداء، تقويم البلدان: ص305؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص365؛ البراقي، تاريخ الكوفة: ص204.
[804] بيزيقيا، بالفتح ثمّ الكسر وياء ساكنة وكسر القاف وياء وألف، قرية قرب حلة بني مزيد، من أعمال الكوفة، وتبعد عن قصر ابن هبيرة تسعة أميال؛ أي: 14كم. ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص183؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص412.
[805] جسر كوثى، ويبعد موضع كوثى عن قصر بن هبيرة خمسة فراسخ، أي: 24 كم، ونهر كوثى هو النهر الرابع الذي يحمل من الفرات إلى دجلة، علماً أنّ مكان كوثى وليس النهر، هو ناحية مشروع جبلة بمحافظة بابل حاليا، وأول النهر هو أسفل نهر الملك بثلاثة فراسخ؛ أي: 14كم، ويصب في نهر دجلة أسفل المدائن بعشرة فراسخ؛ أي: ما يعادل 48كم. ابن خرداذبه، المسالك والممالك: ص185؛ كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية: ص94.
[806] نهر الملك، وهو نهر كبير، أضعاف نهر الصرصر في غزارة مائه، وعليه جسر من سفن للعبور، ونهر الملك مدينة أكبر من صرصر، عامرة بأهلها، وأكثر زرعاً ونخلاً وثمراً، وينتهي النهر إلى قصر ابن هبيرة، ويبعد نهر الملك عن كوثى أربعة أميال؛ أي: ما يعادل 6كم. ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص183؛ أبو الفداء، تقويم البلدان ص305؛ كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية: ص93ـ94.
[807] جسر صرصر،وهما قريتان من سواد بغداد: صرصر العليا وصرصر السفلى، وهما على ضفّة نهر عيسى، وما بين السفلى وبغداد فرسخان؛ أي: تسعة كم، وهو طريق الجنوب من بغداد باتّجاه الكوفة ومكّة، وكان بعد أن يغادر ربط الكرخ يصل إلى صرصر، وهي على نهر صرصر ثاني، الأنهر الكبيرة الآخذة من الفرات ودجلة، ويجري بموازاة نهر عيسى في جنوبه، ويبدأ الطريق الغربي نهر صرصر يصبّ في دجلة، على شيء يسير فوق المدائن، ونهر صرصر الثاني إلى دجلة ومصبّه فوق المدائن بأربعة فراسخ؛ أي ما يعادل 19 كم، وكانت أسفل هذا النهر تُسقى طسوج بادوريا جنوب بغداد الغربي. ابن رسته، الأعلاق النفيسة: ص183؛ أبو الفداء، تقويم البلدان: ص303؛ كي ليسترنج، بلدان الخلافة الشرقية: ص50.
[808] ابن خرداذبه، المسالك والممالك: ص125. ومن الجدير ذكره هنا، أنّ بغداد لم تبنَ في هذا الوقت، عند تسيير سبايا آل البيت إلى الشام.
[809] البردان، مدينة عامرة على شاطئ دجلة الشرقي، وتبعد عن بغداد خمسة فراسخ؛ أي 24 كم. المُهلّبي، المسالك والممالك: ص113؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم من المشرق إلى المغرب: ص161؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص375.
[810] عكبرا، بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الباء الموحدة، وقد يمدّ ويقصّر، مدينة تقع شمال شرق بغداد بمسافة عشرة فراسخ؛ أي مايعادل 48كم. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص161؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص142؛ كي ليسترنج، بلدان الخلافة الشرقية: ص72.
[811] باحمشا، بسكون الميم والشين معجمة، قرية بين اوانا والخطيرة على نهر دجلة القديمة. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص316؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص148.
[812] القادسيّة، بلدة على شرق دجلة، وهي غير قادسية الفرات التي وراء الكوفة، من جهة جزيرة العرب، وقد اشتهرت هذه البلدة بصناعة الزجاج. كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية: ص72.
[813] سرّ من رأى، مدينة كانت بين بغداد وتكريت، على شرق دجلة، وقد خربت. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص173؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج2، ص674.
[814] الكرخ، وهي إحدى محطّات الطريق ما بين بغداد والموصل، وتبعد عن بغداد أربعة وعشرون فرسخاّ، أي: 115كم، وعن سرّ من رأى فرسخان، وعن الموصل ثمانية واربعون فرسخاً، أي: 231 75 كم، وهذا الموضع أقدم من سامراء، ولما بُنِيت سامراء اتصلت بها، وكان الاتراك ينزلون فيه في عهد المعتصم بالله العباسي(218ـ227هـ/833ـ841م). ابن خرداذبه، المسالك والممالك: ص93؛ ابن حوقل: صورة الأرض: ص233؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص449.
[815] جبلتا، وهي إحدى محطّات الطريق بين بغداد والموصل، وتبعد عن سرّ من رأى تسعة فراسخ، أي ما يعادل 43كم، وعن الموصل واحدا واربعين فرسخاً، أي: 197كم، وتبعد عن الكرخ والسودقانية مرحلة واحدة. ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص93؛ المقدسي، أحسن التقاسيم: ص135.
[816] السودقانية، أحد المواضع التي تقع على الطريق الشمالي، وتبعد عن بارما مرحلة، وعن جبلتا مثلها. المقدسي، أحسن التقاسيم: ص135.
[817] بارما، بكسر الراء وتشديد الميم، جبل بين تكريت والموصل، وهو الذي يُعرف بجبل حمرين، وتشقّه دجلة السن، والسن شرق دجلة، فتجري في حافتيه، وفي الماء منه عيون للقار والنفط. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص320؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص151.
[818] السن، بكسر أوله وتشديد نونه، يُقال لها: سن بارما، مدينة على دجلة فوق تكريت، لها سور وجامع كبير، وفي أهلها علماء، وفيها كنائس وبيع للنصارى. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص268؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج2، ص747.
[819] الحديثة، وهي بليدة كانت على دجلة في الجانب الشرقي، قرب الزاب الأعلى. ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص387.
[820] ابن خرداذبه، المسالك والممالك: ص93. ومدينة الموصل، بالفتح وكسر الصاد، مدينة مشهورة، وإحدى قواعد الإسلام، تمتاز برقعتها الواسعة، وكثرة سكّانها، وتمرّ بها القوافل القادمة من جهات شتّى، فهي باب العراق ومفتاح خراسان، ومنها يُقصد إلى آذربيجان، وسُمِّيت بالموصل لأنّها وصلت بين الجزيرة والعراق، ووصلت بين الجزيرة والشام، والجزيرة من عمل سميساط إلى بلد، ومن الموصل إلى الأردن، وقيل: إنّها وصلت بين دجلة والفرات، أو إنّها وصلت بين سنجار والحديثة، وبناها ملك اسمه موصل. يُنظر: ابن الفقيه، البلدان: ص176؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص223.
[821] بلد، هي الموصل القديمة، أو أسكي، وهي بلدة كبيرة خراب، وسورها وأسواقها وأبوابها ظاهرة، وتبعد خمسة فراسخ، أي ما يعادل 24كم عن بادوش. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص484؛ عبد الله البغدادي، النفحة المسكية: ص111، t. Muhammed yolcu، sözlük، p. 35.
[822] تلعفر، بالفاء هكذا تقول عامة النّاس، وأمّا خواصهم فيقولون تل عفر، وقيل: أصله التلّ الأعفر للونه، فغُيّر لكثرة الاستعمال وطلب الخفّة، وهو سن قلعة، وربط بين سنجار والموصل في وسط وادٍ فيه نهر جارٍ، وهي على جبل منفرد حصينة محكمة، وفي ماء نهرها عذوبة، ورطب نخلها يُجلَب إلى الموصل. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص39؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص268.
[823] ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص96. وسنجار، بكسر أوله وسكون ثانيه، مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة الفراتية، وتبعد عن الموصل مقدار ثلاثة أيّام، وهي على جبل عال، وقيل: إنّ سفينة نوح مرّت بهذا الجبل فنطحته، فقال نوح: هذا سن جبل جار علي، فسُمِّي سنجار. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص262؛ الهروي، الاشارات إلى معرفة الزيارات: ص60.
[824] باعيناثا، ياء ساكنة ونون وألف وثاء مثلثة وألف أخرى، قرية كبيرة كالمدينة، فوق جزيرة ابن عمر، لها نهر كبير يصبّ في دجلة، وفيها بساتين كثيرة، وهي من أنزه المواضع، تُشبّه بدمشق. أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج1، ص221؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص325؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص154.
[825] برقعيد، بليدة بين الموصل ونصيبين، عامرة بالسكّان، ولها أسواق كثيرة، وتبعد عن بلد أحد عشر فرسخاً، أي: 53 كم، وعن الموصل سبعة عشر فرسخاً، أي: 82 كم. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص162؛ المُهلّبي، المسالك والممالك: ص109؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ص306.
[826] أذرمة، بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الراء والميم، قرية قديمة من ديار ربيعة، عليها سور، وتتوسّطها قنطرة معقودة بالجصّ والحجارة، على نهر يشقّها، وتبعد عن سنجار عشرة فراسخ، أي ما يعادل 48 كم، وهي اليوم من أعمال نصيبين. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص131؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص47.
[827] ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص95؛ عبد الله البغدادي، النفحة المسكية: ص39.
ونصيبين، بالفتح ثمّ الكسر ثمّ ياء، وعلامة الجمع الصحيح، ومن العرب مَن يعربها فيقول: نصيبون، وهي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة الفراتية، على جادّة القوافل، من الموصل إلى الشام، تقع شمال سنجار، وتبعد عنه تسعة فراسخ، أي ما يعادل 43كم، وتبعد عن الموصل ستة أيّام، ويحيط بها سور، وتمتاز بكثرة مياهها، إذ يجري في وسطها نهر الهرماس الذي يصبّ في نهر الخابور، والتي تقع على أعلاه، ونهر الهرماس، يُسمّى نهر نصيبين أيضاً، وفيها جامع كبير حسن العمارة، وسوق ضيق، والخراب كثير، وفتحت نصيبين صُلحاً في عهد عمر بن الخطاب(13ـ23هـ/634ـ643م) سنة 17هـ/638م، وتقع نصيبين في الوقت الحالي في الجزء الجنوبي الشرقي من تركيا، عند الحدود مع سوريا، قرب مدينة القامشلي. اليعقوبي، البلدان: ص204؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص162؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص288؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1374؛ حنان عبد الخالق، مدينة نصيبين في العصر العباسي دراسة سياسية حضارية: ص15ـ31.
[828] دارا، قرية من قرى دمشق، تقع على سفح جبل، وفيها مياه جارية غزيرة، وتبعد عن نصيبين خمسة فراسخ، أي: 24 كم. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص162؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ص188؛ الحميري، الروض المعطار: ص230.
[829] كفرتوثا، بضم التاء المثناة من فوق وسكون الواو وثاء مثلثة، قرية كبيرة من أعمال الجزيرة، وتبعد عن دارم خمسة فراسخ، أي مايعادل 24 كم، وهي بين دارا ورأس عين، وهي نزه وعامرة، ومياهها جارية. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص162؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص468.
[830] قصر بني نازع، مدينة واقعة على الطريق الذي يصل نصيبين بآمد، وتبعد عن آمد سبعة فراسخ؛ أي: 33 كم، وعن كفر تُوثا ستة فراسخ؛ أي: 28 كم. ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص96.
[831] ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص96؛ الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: ص662. وآمد، مدينة حصينة مبنية بالحجارة، من بلاد الجزيرة الفراتية، وعلى نشز من الأرض، وتُحيط بها دجلة إلّا من جهة واحدة. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص56؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ص491.
[832] الرها، بضم أوله، مدينة في الجزيرة الفراتية، بين الموصل والشام، بينهما ستة فراسخ؛ أي مايعادل 28 كم، وسُمّيت بإسم الذي استحدثها، وهو الرُها بن الباندي بن مالك بن دعر. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص163؛ المُهلّبي، المسالك والممالك: ص110؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص106.
[833] حران، بتشديد الراء وآخره نون، مدينة عظيمة مشهورة، من جزيرة اقور، وتبعد عن الرُها مسافة يوم، وعن الرقّة مسافة يومين، وهي على طريق الموصل والشام والروم، وقيل: إنّها أول مدينة بُنِيت على الأرض بعد الطوفان، ونزلها الصابئة، وتقع حاليّاً جنوب شرقي تركيا عند منبع نهر البليخ، أحد روافد الفرات، وفتحها المسلمون سنة 18هـ/639م، وتشتهر حرّان بسهولها الزراعية. السيرافي، رحلة: ص105؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص163؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص235؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص389؛ كامل بن حسين الحلبي، نهر الذهب في تاريخ حلب: ج1، ص427.
[834] سروج، بفتح أوله وضم ثانيه بعده واو وجيم، مدينة عامرة، قريبة من أرض الجزيرة، وفيه معدن الميس. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص163؛ أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج3، ص737؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص216.
[835] جسر منبج، مدينة قديمة، فُتِحت صُلحاً، تقع على الفرات، ومتّصلة بحدود الشام. اليعقوبي، البلدان: ص207؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص163؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1316.
[836] حلب، مدينة عظيمة واسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، وهي قصبة جند قنسرين. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص176؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص282؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ص183؛ العمري، مسالك الأبصار: ج3، ص535.
[837] قنسرين، بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده وسين مهملة، وهي في الإقليم الرابع، وتبعد عن حَلَب اثنا عشر ميلاً، أي ما يعادل 19 كم. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص403؛ الحميري، الروض المعطار: ص473.
[838] الاصطخري، مسالك الممالك: ص65.
[839] باجروان، بفتح الجيم والراء المهملة الساكنة وبعدها واو وألف ونون، وهي من أرض البليخ، وتبعد عن الفرات ليلة. أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج1، ص220؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص313؛ الحميري، الروض المعطار: ص74.
[840] ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص76.
[841] الجزيرة الفراتية، وتقع بين دجلة والفرات، وحدّها من الجنوب الخطّ الوهمي الواصل بين تكريت على نهر دجلة وهيت على نهر الفرات، وحدّها من الغرب بلاد الشام، وحدّها من الشرق إقليم آذربيجان وجبال أرمينيا، وحدّها من الشمال الخطّ الوهمي الممتدّ شمالاً إلى ميافارقين، وينحدر جنوباً باتّجاه الغرب إلى نصيبين وسميساط على الفرات، وتنقسم الجزيرة إلى ثلاثة أقسام، هي: ديار ربيعة وقاعدتها الموصل، وديار مضر وقاعدتها الرقّة، وديار بكر وقاعدتها امد، نسبة إلى القبائل العربية التي سكنتها من ربيعة ومضر وبكر. الاصطخري، مسالك الممالك: ص52؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص134؛ أبو الفداء، تقويم البلدان: ص274؛ عصام الرؤوف، بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي: ص218.
[842] الفتوح: ج5، ص127؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص72.
[843] الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص35؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص72؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105.
[844] الفراهيدي، العين: ج4، ص51؛ ابن سيده، المخصّص: ج2، ص97.
[845] الفراهيدي، العين: ج5، ص163؛ ابن منظور، لسان العرب: ج15، ص10.
[846] مقتل الحسين ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء، المعروف بأبي مخنف: ص122ـ130. يُنظر: خارطة رقم (6): ص474.
[847] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص89.
[848] يُنظر: ملحق رقم(18): ص488.
[849] يُنظر: ابن خرداذبة، المسالك والممالك: ص184ـ185؛ ملحق رقم(19): ص489 ـ 490.
[850] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص98.
[851] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص98؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص83؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص467.
[852] الضلع: الغمز، كأن في رجله داء، أي بمعنى يعرج. الفراهيدي، العين: ج2، ص86؛ الجوهري، الصحاح ج3، ص1256؛ ابن منظور، لسان العرب: ج8، ص243.
[853] اكف والاكف والإكاف، وجمعه آكفةٌ وأكفٌ، وهو الرحل الصغير على قدر السنام، أي شددت على الدابة الرحل، والرحل من إزار وآزرة وأزر. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج4، ص1331؛ الرازي، مختار الصحاح: ص18؛ ابن منظور، لسان العرب: ج9، ص9؛ الزبيدي، تاج العروس: ج12، ص87.
[854] الفارطة: الفرط، الشتم، وفرط عليه: آذاه، وفرط: أعجله. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج2، ص377 الزبيدي، تاج العروس: ج11، ص359؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج4، ص264.
[855] ابن طاووس، إقبال الأعمال: ص89؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص154.
[856] الدير وجمعه أديرة، أديار، والدير هو: خان للنصارى والمكان الذي يتعبّد الرهبان فيه في أدائهم للصلاة والتقرّب إلى الله تعالى؛ ليمنّ عليهم ويبارك فيهم، ويُقصَد الدير لزيارة القبور التي بالقرب منه، والدير غالباً ما يكون بناؤه في الصحاري أو رؤوس الجبال أو مطل على أودية، أو في السهول الفسيحة الخضراء، وفي المواضع المنقطعة عن النّاس، ولا يُبنى في المدينة، واذا بني يُسمّى كنيسة، ولكل دير عيد خاصّ به، ما عدا الأعياد التي يشترك بها النصارى، وساكنه وعامله يُسمّى ديراني وديار، والمرأة تُسمّى ديرية وديرانية، وقد انتشرت هذه الديارات، في الأرض العربية منذ عصور ما قبل الإسلام. الفراهيدي، العين: ج2، ص58؛ الشابشتي، الديارات: ص50؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج2، ص318؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص495؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص300؛ العمري، مسالك الأبصار في ممالك الامصار: ج1، ص260؛ محمّد سعيد، الديارات والامكنة النصرانية في الكوفة وضواحيها: ص70؛ حنان عبد الرحمن الملّا طه، الديارات النصرانية في العراق ونشاطاتها العلمية والفكرية حتى نهاية العصر العباسي: ص7ـ57.
[857] سرجس وبكس هما راهبان من نجران، منسوب لهما هذا الدير، وهو بين الكوفة والقادسيّة، ويبعد عن القادسيّة ميلا واحدا، وكان كثير الكروم والأشجار، وفيه الخانات والمعاصر، وكانت أرضه من المواضع المقصودة بما تُوصَف من نزاهتها، واشار الشابشتي(ت 388هـ/998م) إلى أنّ هذا الدير قد أصابه الخراب، وعفت آثاره، وتهدّمت آباره، ولم يبق منه إلّا قباب خراب وحجرة في الطريق، وتُسمّى من قِبَل النّاس: معصر أو قباب أبي نؤاس، وكان هذا الدير من أحسن الديارات عمارةً، وأنسبها موضعاً. يُنظر: الشابشتي، الديارات: ص233؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص514؛ الخزل والدأل بين الدور والدارات والديرة: ج2، ص74.
[858] ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص6؛ الراوندي، الخرائج والجرائح: ص572.
[859] سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ج3، ص108؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص363.
[860] ابن المغازلي، مناقب علي بن أبي طالب: ص311؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص101؛ هاشم البحراني، مدينة المعاجز: ج4، ص106.
[861] سليمان بن مهران الاعمش، أبو محمّد الاسدي الكاهلي، مولاهم الكوفي، وأصله من نواحي الري، وقيل: وُلد في قرية أمّه من أعمال طبرستان سنة 61هـ/680م، وكان أبوه من دنباوند، وقد قدم به إلى الكوفة طفلاً، وقيل: أمّه حاملاً به، وكان حافظاً ثقةً عالماً فاضلاً، شيخ القرّاء والمحدّثين، وتُوفّي في ربيع الاول سنة 148هـ/765م. ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص400؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج6، ص227؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج10، ص112؛ غصون عبد صالح، سليمان بن مهران الاعمش ومروياته التاريخية: ص7 ـ 138.
[862] ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص76؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص224.
[863] الصدوق، الأمالي: ص193؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص193.
[864] الديار بكري، تاريخ الخميس، : ج2، ص333.
[865] المفيد، محمدبن محمّد بن النعمان، الإرشاد: ج2، ص119.
[866] محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص535.
[867] محمّد عبد الغني السعيدي، من كربلاء إلى دمشق رحلة سبايا آل بيت المصطفى’ 61هـ/680م شواهد تاريخية: ص143.
[868] الحصّاصة: بالفتح وتشديد ثانيه، من الحص، وهو ذهاب الشعر عن الرأس، والنبت عن الأرض، وهي من قُرى السواد، قرب قصر ابن هبيرة، من أعمال الكوفة. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص263؛ البراقي، تاريخ الكوفة: ص185.
[869] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص122.
[870] مقتل الحسين ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء، المعروف بمقتل أبي مخنف: ص122؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص535.
[871] بابل، بكسر الباء الثانية، وقيل: إنّها سُمّيت ببابل لأنّ النّاس اجتمعوا فيها، واختلفت ألسنتهم فيها وتبلبلت، وأنّ الملوك اجتمعوا فيها ثمّ تفرّقوا، وقيل: إنّ الكلدانيين هم الذين كانوا يسكنون فيها، وقيل: إنّ أول مَن سكنها النبي نوح وعمّرها. ابن الفقيه، كتاب البلدان: ص334؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص160؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص309؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص145. يُنظر: خارطة رقم (10): ص478.
[872] يُنظر: خارطة رقم (11): ص479؛ ملحق رقم(20): ص491.
[873] يُنظر: خارطة رقم (11): ص479.
[874] حمارات، وهي قرية من قرى الدجيل، وتبعد عن نهر الحسيني أربعة فراسخ، أي: 19 كم. عبد الله البغدادي، النفحة المسكية: ص94.
[875] الفرحاتية وعلى مرحلة منها نهر يُسمّى باسمها، وهي من أعمال الدجيل، وتبعد عن حمارات ستّة أميال ونصف تقريباً، أي: 9 كم. عبد الله البغدادي، النفحة المسكية: ص94؛ عباس الربيعي، أطلس الحسين: ص322.
[876] المحادر، سُمّيت بهذا الاسم؛ لانحدار سطح أرضها، وموقعها مقابل سامراء. عبد الله البغدادي، النفحة المسكية: ص94؛ عباس الربيعي، أطلس الحسين: ص322.
[877] مهيجر، موضع قرب سامراء، عبارة عن تلّ صغير مدوّر قرب دجلة، عبد الله البغدادي، النفحة المسكية: ص43.
[878] ابن خرداذبه، المسالك والممالك: ص93؛ المقدسي، أحسن التقاسيم: ص134.
[879] تكريت، بفتح التاء، والعامّة يكسرونها، بلدة مشهورة بين بغداد والموصل، والى بغداد أقرب، وتبعد عنها ثلاثون فرسخاً، أي: 144 كم، ولها قلعة حصينة، ومن طرفها الأعلى راكبة على دجلة، وهي غربي دجلة. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص38؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص268.
[880] مقتل الحسين ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء، المعروف بمقتل أبي مخنف: ص122؛ سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ص351؛ فخر الدين الطريحي، المنتخب: ص481؛ إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص370؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص535.
[881] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص122؛ سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ص351؛ فخر الدين الطريحي، المنتخب: ص481؛ الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص370؛ زهير بن علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف: ج2، ص66.
[882] وادي النخلة، ناحية من نواحي الموصل الشرقية، قرب الخازر، وهو اسم الكورة التي يسقيها الخازر. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص276؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1363.
[883] أبو مخنف، مقتل الحسين: ص122؛ إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص371؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص366.
[884] عباس الربيعي، أطلس الحسين: ص332.
[885] البلاليق: جمع بلوقة، وهي فجوات في الرمل، تنبت الرخامى وغيره، وهو بقل، موضع بين تكريت والموصل، ويُقال لها البلاليج. عبد الله البغدادي، النفحة المسكية: ص98؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص478.
[886] عباس الربيعي، أطلس الحسين: ص332.
[887] الكورة، اسم فارسي يقع على قسم من أقسام الاستان(البلاد)، وقد استعارتها العرب وجعلتها اسماً للاستان، والكورة هي كلّ صقع يشتمل على عدد من القرى، أي المدينة وما يتبعها من القرى. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص36.
[888] ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص29.
[889] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص123؛ إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص371؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص536.
[890] الكحيل، وهو تصغير الكحل، وهي قرية تحت الموصل على شاطئ دجلة الغربية، مقابل الحديثة. ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1350.
[891] موسوعة كربلاء: ج2، ص369.
[892] المنتخب: ص468.
[893] جُهينة، لفظ للتصغير، وهو اسم لقبائل قضاعة، وسُمّيت به قرية كبيرة، من نواحي الموصل على دجلة، وهي أول منزل لِمَن يريد بغداد من الموصل، وفيها مرج يُقال له: مرج جهينة. ابن خرداذبه، المسالك والممالك: ص94؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص194؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص363.
[894] موسوعة كربلاء: ج2، ص369ـ371؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص540. وعَسقلان: بفتح أوله وسكون ثانيه ثمّ قاف وآخره نون، وهي مدينة في الشام، من أعمال فلسطين، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بين غزّة وبيت جبرين، ويُقال لها: عروس الشام، نزلها جماعة من الصحابة والتابعين، ولم تزل عامرة حتى استولى عليها الفرنج. أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج3، ص943؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص122.
[895] محمّد عبد الغني السعيدي، من كربلاء إلى دمشق: ص244. وحمام العليل، وحمام علي باصطلاح أهل الموصل، وهي بين الموصل وجُهينة، قرب عين القار، غربي دجلة، وهي عين ماء حارّ كبريتي، وفيها منافع. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص299.
[896] يُنظر: ملحق رقم(15): ص485.
[897] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص123؛ سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ص351؛ محمّد جعفر الطبسي، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة وقائع الطريق من كربلاء إلى الشام: ج5، ص200؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص371؛ زهير بن علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف: ج2، ص69.
[898] عباس القمّي، نفس المهموم: ص426؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص102.
[899] الهروي، الاشارات إلى معرفة الزيارات: ص60.
[900] لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص372.
[901] يُنظر: خارطة رقم (7): ص475؛ ملحق رقم(12): ص480ـ 481.
[902] يُنظر: ملحق رقم (16): ص486.
[903] الخاتونية، تقع في الجهة الشمالية الشرقية في محافظة الحسكة السورية، وتبعد عن مركز المدينة 50 كم، بمحاذاة حدود العراق، مع امتداد سلسلة جبال سنجار. لم نجد لها تعريفاّ في المصادر الجغرافية والبلدانية التي بين أيدينا إلّا في الموسوعة الحرّة، www. wikipedia. org.
[904] معبد العيون، ويقع في تل براك، وقد عُثِر فيه على محتويات ومكتشفات اثرية هامّة، ومنها بناء مدرج ومعبد. ولم نجد لها تعريفاّ في المصادر الجغرافية والبلدانية التي بين أيدينا إلّا في الموسوعة الحرّة، www. wikipedia. org.
[905] تل براك، يقع غرب نهر جغجغ، أحد روافد نهر الخابور، ويبعد مسافة 42 كم من الحسكة السورية، وهو من التلال الاثرية، والذي يعود إلى ستّة آلاف سنة ق. م، وعلى هذا التل كان مقرّ نارم سين ملك مملكة ابلا، وكان قوي التحصين منيعاً. ولم نجد لها تعريفاّ في المصادر الجغرافية والبلدانية التي بين أيدينا إلّا في الموسوعة الحرّة، www. wikipedia. org.
[906] بئر الحلو، لم نعثر على تعريف له في المصادر التي بين أيدينا.
[907] خريبة ظاهر، لم نعثر على تعريف له في المصادر التي بين أيدينا.
[908] تل الذهب، لم نعثر على تعريف له في المصادر التي بين أيدينا.
[909] الكيطة، لم نعثر على تعريف له في المصادر التي بين أيدينا.
[910] القامشلي، سُمّيت المدينة قبل توسّعها بالسريانية بـ"بيت زالين"، وتعني مكان القصب، نسبة إلى القصب المنتشر حول نهر الجغجغ المارّ بها. كما سُمّيت لاحقا باسمها الحالي "القامشلي"، وهي تكريد لمعنى الكلمة السريانية، حيث تعني قامش "kamış" "قاميش" القصب باللغة الكردية، تقع المدينة بالقرب من آثار مدينة أوركيش القديمة تل موزان حالياً التابعة للحوريين، التي تأسّست خلال الألفية الرابعة قبل الميلاد. ويُعدّ السريان من أوائل مَن سكن المنطقة حيث وفدوا من نصيبين، ثمّ تلاهم الأكراد والأرمن وقبائل بني بكر العرب والمردللية نسبة إلى ماردين تقع مدينة القامشلي في جنوب جبال طوروس، حيث تُعدّ مكاناً خصباً زراعياً لأنّها لا تبتعد أكثر من 10 كم عن جبال طوروس. يحدّ المدينة من الشرق ناحية القحطانية، ومن الجنوب الشرقي ناحية تل حميس، ومن الغرب ناحية عامودا، أمّا من الشمال فمدينة نصيبين التركية، حيث يفصل بين مدينتي القامشلي ونصيبين الخط الحدودي السوري ـ التركي فقط، حيث بالإمكان رؤية مدينة نصيبين من أسطح أبنية القامشلي والعكس صحيح، تبلغ مساحة المدينة دون نواحيها بـ 38 كم2. لم نجد لها تعريفاّ في المصادر الجغرافية والبلدانية التي بين أيدينا إلّا في الموسوعة الحرّة، www. wikipedia. org.
[911] لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[912] لم نعثر له على ترجمة، وهو غير إبراهيم الموصلي الذي عاش في العصر العباسي، وُلِد سنة 125هـ/742م، وتُوفّي في بغداد سنة 188هـ/804م، وقيل 213هـ/828 م. يُنظر: أبو سعد السمعاني، الأنساب: ج5 ص407؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج1 ص42؛ اليافعي، مرآة الجنان: ج1 ص324.
[913] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص360؛ عباس القمّي، نفس المهموم: ص426؛ محمّد جعفر الطبسي، مع الركب الحسيني من المدينة إلى المدينة وقائع الطريق من كربلاء إلى الشام: ج5، ص200.
[914] دعوات، لم نعثر على تعريف لها في المصادر التي بين أيدينا.
[915] عين الوردة، وهي مدينة مشهورة في الجزيرة الفراتية، وحدثت على أرضها معركة بين التوابين المطالبين بالثأر للإمام الحسين×، وجيش بني أميّة بقيادة عبيد الله بن زياد، سنة 65هـ/684م، وكان النصر لبني أميّة. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص180؛ الحميري، الروض المعطار: ص423. تفاصيل أوسع عن عين الوردة يُنظر: خالد راسم أمير، حركة التوابين 61ـ65هـ/680ـ684م دراسة تاريخية: ص206.
[916] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص124.
[917] قلعة دوسر، دوسر، بفتح أوله وسكون ثانيه وسين مهملة وراء، قرية قرب صفين على الفرات، قيل: إنّها قلعة جعبر أو ربضها. أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج2، ص562؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص484.
[918] محمّد عبد الغني السعيدي، من كربلاء إلى دمشق: ص369ـ374؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص379. وبالس، بلدة في الشام، بين حلب والرقّة، وسُمّيت بهذا الاسم نسبة إلى بالس بن الروم بن اليقن بن سام بن نوح، وتقع على ضفة الفرات الغربية، وقد شرق الفرات عنها قليلاً قليلاً حتى أصبحت المسافة بينهما أربعة أميال، أي: 6 كم. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص176؛ المُهلّبي، المسالك والممالك: ص66؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص328.
[919] الجوشن، بالفتح ثمّ السكون والجيم معجمة، وهو جبل مطلّ على حلب من جهتها الغربية، وعلى سفحه مقابر ومشاهد للشيعة، ومنه يُحمل النحاس الأحمر، وقيل: إنّه بطل منذ أن عبر عليه سبايا آل البيت. وكانت إحدى زوجات الإمام الحسين× حاملاً فأسقطت هناك، وطلبت من صناع الجبل خبزاً وماءاً فشتموها ومنعوها، فدعت عليهم، فصار مَن يعمل في ذلك الجبل لا يربح. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص186؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص359؛ ابن شداد، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: ص21؛ ابن الوردي، خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ص278.
[920] ابن العديم، بغية الطلب: ج1، ص411.
[921] ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص186.
[922] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص124.
[923] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص125؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص380؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص542.
[924] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ج2، ص115ـ116.
[925] معرة النعمان، سُمّيت هذه المدينة نسبة إلى الصحابي النعمان بن بشير الأنصاري، وقد اجتاز بها ومات، ودفنه ولده فيها، والى جانب سورها قبر يشوع بن نون، وقبر عبد الله بن عمّار بن ياسر أيضا. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص156؛ القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد: ص272.
[926] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص125؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص382.
[927] شيزر، بتقديم الزاي على الراء وفتح أوله، قلعة تشتمل على كورة في الشام، قرب المعرة، وتبعد عن حماة مقدار يوم، ما يُعادل تسعة أميال، أي: 14كم، وعن حمص ثلاثة وثلاثين ميلاً، أي: 53 كم، وعن انطاكيا ستة وثلاثين ميلاً، أي: 57 كم، ولها سور من اللبن، وفيه ثلاثة أبواب، ويمرّ في وسطها نهر الأردن، وعليه قنطرة في وسط المدينة، وأوله من جبل لبنان. مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص176؛ المُهلّبي، المسالك والممالك: ص94؛ أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج3، ص818؛ الزمخشري، الجبال والأمكنة والمياه: ص195؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص383.
[928] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص125؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص383.
[929] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص125؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص384؛ زهير ابن علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف: ص73.
[930] كفر طاب، الطاء المهملة وبعدها الف ثمّ باء موحّدة، بلدة بين المعرة وحلب، في برية معطشة، شربهم ما يجمعونه من مياه الأمطار في الصهاريج. المُهلّبي، المسالك والممالك: ص102؛ الزمخشري، الجبال والأمكنة والمياه: ص285؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص470؛ الحميري، الروض المعطار: ص500؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1170.
[931] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص125؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص544؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص383؛ زهير بن علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف: ص73.
[932] حماة، بالفتح، وهي مدينة كبيرة، كثيرة الخيرات، رخيصة الأسعار، واسعة الرقعة، حافلة الأسواق، ويحيط بها سور محكم، وبظاهر السور حاظر كبير، وفيه أسواق كثيرة، وجامع مفرد مشرف على نهرها المعروف بالعاصي. السيرافي، رحلة: ص99؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص176؛ أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج2، ص466؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص300.
[933] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص126؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص544؛ زهير ابن علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف: ص74.
[934] الرستن، بفتح أوله وسكون ثانيه وتاء مثنّاة من فوق وآخره نون، بليدة قديمة، وكانت على نهر الميماس، ويُعرف اليوم بنهر العص، ويقع الرستن في منتصف المسافة بين حَماة وحمص، وفي هذا الموضع بقايا آثار تدلّ على عمارتها السابقة، وهي الان خراب لا يوجد فيها مرعى. الهروي، الاشارات إلى معرفة الزيارات: ص18؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص43؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج2، ص615؛ عبد الله البغدادي، النفحة المسكية: ص215.
[935] خالد بن النشيط، لم نعثر على ترجمة له في المصادر التي بين أيدينا.
[936] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص127.
[937] المصدر السابق؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص385.
[938] يُنظر: ملحق رقم(17): ص487.
[939] بعلبك، بالفتح ثمّ السكون وفتح اللام والباء الموحّدة والكاف المشدّدة، مدينة قديمة، وابنيتها عجيبة، وآثارها عظيمة، وقصورها على اساطين من الرخام، وتبعد عن دمشق مقدار ثلاثة أيّام، وقيل: اثنا عشر فرسخاً، أي: 57 كم. السيرافي، رحلة: ص104؛ مؤلِّف مجهول، حدود العالم: ص176؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص453.
[940] الجوسية، بالضمّ ثمّ السكون وكسر السين وياء، قرية من قُرى حمص، وتبعد عنها ستّة فراسخ، أي: 28 كم من جهة دمشق، بين جبل لبنان وجبل سمير، وفيها عيون تسقي أكثر ضياعها سيحاً، وهي كورة من كور حمص. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص185؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص358؛ يُنظر: ملحق رقم (14): ص484.
[941] اللبوة، بلدة لبنانية من قرى بعلبك، وتعود تسميّتها إلى اللغة الآرامية، وتعني القلب أو الوسط، ولكن هناك مَن يرى أنّ اصل تسميّتها عربية، بمعنى اللبوة أنثى الأسد. لم نجد لها تعريفاّ في المصادر الجغرافية والبلدانية التي بين أيدينا إلّا في الموسوعة الحرّة، www. wikipedia. org.
[942] الخلوق، بفتح الخاء وضمّ اللام، وهو نوع من الطيب للنساء، معمول من الزعفران، تغلب عليه الصفرة والحمرة. ابن عبد البر، الاستذكار: ج4، ص29؛ محمّد بن مكّي العاملي الشهيد الأول، ذكرى الشيعة: ج2، ص240؛ الزبيدي، تاج العروس: ج13، ص123.
[943] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص127؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص387؛ زهير ابن علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف: ص76. وبلفظ آخر لدعاء أمّ كلثوم على أهل هذه المدينة. يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص127؛ سليمان ابن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ج3، ص89.
[944] الصومعة، وهي ما رفع واستدقّ رأسه، بيت العبادة للمتعبّد والنّاسك عند النصارى، وقد ورد ذكر الصومعة في القرآن الكريم بمعنى معابد الرهبان، قال الله تعالى: (...وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ...) (الحج: آية40)، ولتفسير هذه الآية يُنظر: محمّد علي الصابوني، صفوة التفاسير: ج2، ص268. وتحتوي الصومعة على خزانة، تُوضع فيها كتب الراهب ومقتنياته الأخرى، وتشتهر بعض الأديرة بكثرة صوامعها، ولرئيس الدير صومعة خاصّة به. الشابشتي، الديارات: ص50؛ الحميري، شمس العلوم ودواء كلام العرب من كلوم: ج6، ص3829؛ الزمخشري، أساس البلاغة: ص200؛ الزبيدي، تاج العروس: ج21، ص359؛ حنان عبد الرحمن الملّا طه، الديارات النصرانية في العراق ونشاطاتها العلمية والفكرية حتى نهاية العصر العباسي: ص11.
[945] الراهب، وجمعه رُهبان ورهابنة، ولفظه من الرهبنة، ومعناها الخوف، ويُقال ترهّب الرجل، أي صار راهباً متعبّداً منقطعاً في الصومعة، وقد ورد ذكر الرهبان في القرآن الكريم، لتواضعهم وقولهم الحق، قال الله تعالى: (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ) (المائدة: آية82)، ولتفسير هذه الآية يُنظر: الطبري، جامع البيان: ج5، ص2؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: ج6، ص255. وللتفصيل عن مصطلح الراهب يُنظر: الشابشتي، الديارات: ص267؛ ابن سيّده، المحكم والمحيط الأعظم: ج4، ص310؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص1237؛ أحمد الشنشتاوي وآخرون، دائرة المعارف الإسلامية، م10: ص9؛ رغد عبد النبي جعفر المالكي، الرهبانية النصرانية في مصر من القرن الثالث الميلادي إلى القرن الخامس الميلادي: ص6.
[946] معربون، وهو موضع حدودي بين لبنان وسوريا، من قرى قضاء بعلبك، في محافظة بعلبك الهرمل، وتبلغ مساحتها 1120 هكتار. لم نجد لها تعريفاّ في المصادر الجغرافية والبلدانية التي بين أيدينا إلّا في الموسوعة الحرّة، www. wikipedia. org.
[947] يُنظر: ملحق رقم(13): ص483
[948] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص128؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص387؛ زهير ابن علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله الحسين× من موروث أهل الخلاف: ص77.
[949] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص128؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص387؛ زهير علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله: ص77.
[950] الشعراء: آية227.
[951] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص128؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص387؛ زهير علي الحكيم، مقتل أبي عبد الله: ص77.
[952] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص334.
[953] المصدر السابق.
[954] المصدر السابق.
[955] المصدر السابق.
[956] إبراهيم: آية42.
[957] الشعراء: آية227.
[958] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص334.
[959] يعقوب العسقلاني، لم نعثر على ترجمة له في المصادر التي بين أيدينا.
[960] زريد الخزاعي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[961] إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص376ـ377.
[962] سرغايا، فتح أوله وسكون ثانيه وغين معجمة، وهو الحدّ بين أول الحجاز وآخر الشام، بين المغيثة وتبوك، من منازل الحاج الشامي. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص211؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج2، ص707.
[963] الزبداني، بفتح أوله وثانيه ودال مهملة وبعد الألف نون وياء مشدّدة كياء النسب، كورة معروفة مشهورة، بين دمشق وبعلبك، ويخرج لها نهر دمشق بمسافة ستّة فراسخ، أي: 28 كم. السيرافي، رحلة: ص104؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص130.
[964] التكية، وتقع على الضفة اليسرى لنهر بردى، وأعظم من نهر دمشق، ومخرجه من قرية يُقال لها قنوا، من كورة الزبداني، على بعد خمسة فراسخ، أي: 24 كم من دمشق، ممّا يلي بعلبك. عبد القادر بن بدران، منادمة الاطلال ومسامر الخيال: ص369؛ أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج1، ص240؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص378.
[965] عين الفيجة، بالكسر ثمّ السكون وجيم، قرية بين دمشق والزبداني، وعند مخرج نهر دمشق بردى. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص282؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1049.
[966] الهامة، وهي إحدى المواضع القريبة من دمشق. الزمخشري، الجبال والأمكنة والمياه: ص331.
[967] دمر، تشديد أوله وثانيه والراء المهملة، قرية من قرى الغوطة، وتقع على نهر بردى. أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج2، ص556.
[968] محمّد عبد الغني السعيدي، من كربلاء إلى دمشق: ص596. والربوة، وتبعد مقدار فرسخ، أي: 4 كم عن دمشق، في وادي بردى. ابن الوردي، خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ج1، ص282.
[969] بهاء الدين محمّد بن حسين العاملي، توضيح المقاصد: ص5؛ عباس القمّي، نفس المهموم: ص391؛ إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين في أنصار الحسين×: ص379.
[970] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص362؛ عباس القمّي، نفس المهموم: ص371؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص551. يُنظر: خارطة رقم (7): ص475.
[971] يُنظر: مخطط رقم (8) لمدينة دمشق القديمة المسورة: ص476.
[972] مقبرة الباب الصغير، وهي من المقابر الأثرية القديمة، تقع ما بين الباب الصغير وباب الجابية، دُفِن فيها عدد من الصحابة والتابعين والحكّام والأمراء، وهذه المقبرة ما تزال موجودة اليوم، وتُعرَف بهذا الاسم أيضاً. أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر: ص194؛ العمري، مسالك الأبصار: ج8، ص201؛ عبد القادر بن بدران، منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: ص373؛ ابن جبير، الرحلة: ص254؛ ابن بطوطة، الرحلة: ص320.
[973] موسوعة كربلاء: ج2، ص431.
[974] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص215؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص220؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص389؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص128؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص122؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين، ص192؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص40؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج10، ص94؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص87؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص336؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج6، ص2631؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص317؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص255؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص475؛ الدميري، حياة الحيوان: ج1، ص92؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ج2، ص838.
[975] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص135.
[976] مشاش، كلّ عظم يمكن مضغه. ابن سيده، المخصّص: ج1، ص138؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج2، ص288.
[977] البلاذري، أنساب الأشراف، ج5، ص298؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص67؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص363.
[978] الفتوح: ج5، ص135.
[979] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص81؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص101.
[980] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص212؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص101.
[981] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص216؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354؛ ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص82.
[982] البلاذري، أنساب الأشراف: ج11، ص33؛. وفي لفظ مقارب في المعنى، يُنظر: ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص211.
[983] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص98.
[984] سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص330.
[985] المصدر السابق.
[986] المصدر السابق.
[987] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص213؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج11، ص33؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص118؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج18، ص445؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص798.
[988] الدينوري، الأخبار الطوال: ص260؛ الدميري، حياة الحيوان: ج1، ص92؛ الديار بكري، تاريخ الخميس: ج2، ص324. الرخم، رخمت النعامة أو الدجاجة على بيضها، ورخمت عليه أي: حضنته. ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص233؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص215.
[989] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص351؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص342؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص83؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج6، ص2631؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج14، ص127؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص208.
[990] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص212؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص261؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص212؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج18، ص445؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص208؛ الدميري، حياة الحيوان: ج1، ص92.
[991] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج18، ص335؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج8، ص3785.
[992] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص82. والجعجع، الحبس والتضيّق، أو أصوات الجمال اذا أجتمعت. يُنظر: ابن سلام، غريب الحديث: ج4، ص483؛ الجوهري، الصحاح: ج3، ص1197؛ ابن منظور، لسان العرب: ج8، ص50.
[993] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص67ـ68.
[994] العقد الفريد: ج5، ص131.
[995] فخر الدين الطريحي، المنتخب: ص470.
[996] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص66ـ67.
[997] المصدر السابق: ج2، ص67ـ68.
[998] المصدر السابق: ج2، ص80.
[999] الطبراني، المعجم الكبير: ج3، ص116؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج65، ص86؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص330؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج5، ص18؛ ابن حجر الهيثمي، مجمع الزوائد: ج9، ص198.
[1000] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص83؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص161؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص319؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج12، ص264؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص222؛ الباعوني الشافعي، جواهر المطالب: ج2، ص299.
[1001] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص219.
[1002] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص362؛ عباس القمّي، نفس المهموم: ص391؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص551.
[1003] البيروني، الآثار البقية: ص331؛ القزويني، عجائب المخلوقات: ص45.
[1004] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص362؛ عباس القمّي، نفس المهموم: ص391؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص551.
[1005] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص130؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص67.
[1006] عباس القمّي، نفس المهموم: ص391؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص551.
[1007] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص45.
[1008] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص130؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج3، ص369.
[1009] الراية، هي العَلَم، وجمعها الرايات، والراية، اللواء، وجمعه ألوية، ولا يمسكها إلّا صاحب الجيش. الجوهري، الصحاح: ج5، ص1990؛ ابن منظور، لسان العرب: ج15، ص266.
[1010] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص130؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج3، ص369.
[1011] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص67؛ عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص361؛ باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج3، ص369.
[1012] باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج3، ص369.
[1013] يقع في الطرف الغربي من مدينة دمشق، ومنسوبٌ إلى قرية الجابية، لانّ الخارج لها يخرج من هذا الباب، وكان لباب الجابية، ثلاثة أبواب، الأوسط كبير، وعلى جانبيه بابان صغيران، وللأبواب الثلاثة ثلاثة أسواق، تمتدّ من باب الجابية إلى الباب الشرقي، السوق الكبير في الباب الأوسط يكون للناس، والسوقان الآخران، أحدهما للذاهب إلى جهة الشرق، والآخر للذاهب إلى جهة الغرب، وقد سُدّ الباب الكبير والباب الشامي وبقي الباب القبلي، وهو الباب الجنوبي الصغير، ومن هذا الباب دخل أبو عبيدة عامر بن الجراح ت سنة 18هـ/639م، عند فتح المدينة صلحاً في سنة 14هـ/635م. يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج2، ص408؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص152؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج1، ص56؛ عبد القادر بن بدران، منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: ص39؛ قتيبة الشهابي، معجم دمشق التاريخي: ج1، ص20ـ21.
[1014] هو من الأبواب القديمة لدمشق، وقد أُطلِق على هذا الباب بعد الفتح الإسلامي لدمشق في سنة 14هـ/635م اسم الباب الصغير؛ لكونه أصغر أبواب المدينة، كما يُطلق عليه الباب القبلي أيضاً وباب الحديد. يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج2، ص407؛ عبد القادر بن بدران، منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: ص40؛ قتيبة الشهابي، معجم دمشق التاريخي: ج1، ص26.
[1015] هو أحد أبواب دمشق، ويُنسب إلى كيسان مولى معاوية بن أبي سفيان، وروى عنه، وهو من الطبقة الرابعة من أهل دمشق والأردن، وكنيته أبو حريز، وقيل: إنّ اسمه حريز. يُنظر: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ج7، ص165؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج2، ص407، و ج50، ص281؛ العمري، مسالك الأبصار: ج3، ص512؛ بدران، منادمة الاطلال: ص40؛ ابن ناصر الدين الدمشقي، توضيح المشتبه: ج2، ص290؛ قتيبة الشهابي، معجم دمشق التاريخي: ج1، ص28.
[1016] يقع في الجهة الشرقية لسور المدينة، ويتكوّن هذا الباب من ثلاثة أبواب، أكبرها الأوسط، وقد نزل عليه خالد بن الوليد يوم فتح دمشق. يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص465؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج1، ص22؛ الحميري، الروض المعطار: ص237؛ قتيبة الشهابي، معجم دمشق التاريخي: ج1، ص26.
[1017] ابن الفقيه، البلدان: ص157؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج5، ص425. وباب الفراديس يقع في الجهة الشمالية من الجامع، وقريباً من جبل قاسيون، ومدفن سبعين الف نبي، وفيه مشهد للإمام الحسين×. يُنظر: أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج1، ص254؛ الهروي، الإشارات إلى معرفة الزيارات: ص22؛ ابن جبير، الرحلة: ص222؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص242؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج3، ص1021؛ قتيبة الشهابي، معجم دمشق التاريخي: ج1، ص26.
[1018] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص361.
[1019] قصر الخضراء، وهو من القصور الأموية في دمشق، بناه معاوية بن أبي سفيان أيّام ولايته في دمشق؛ داراً للحكم، ويقع قبل المسجد الأموي الكبير، بُنيت عليه قبّة خضراء، ولذلك عُرِف القصر بهذا الأسم، سكنه معاوية أربعين سنة. وقيل: إنّ قصر الخضراء من بناء أهل الجاهلية، من البناء القديم. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج2، ص363؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج9، ص166؛ محمّد كرد علي، خطط الشام: ج5، ص246.
[1020] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص165.
[1021]بُنيَ على أرض المعبد، يُنسب للاله حدد، أقامه أهل دمشق في العهد الآرامي في مطلع الألف الأول قبل الميلاد، وبنى الرومان بعد دخولهم إلى دمشق معبداً لهم في المكان نفسه، وعندما تنصّر أهل الشام على يد الملك قسطنطين(272ـ337م) بنوا كنيستهم على أرض هذا المعبد، وكانت تُسمّى كنيسة مريحن، أو كنيسة يوحنا، وبعد أن فتح المسلمون بلاد الشام (معركة اليرموك) في سنة 15هـ/636م، أخذوا الجانب الشرقي من كنيسة مريحن وأقيم عليه المسجد، وبهذا صار المكان وبابه الرئيسي مشتركاً بين المسلمين والنصارى، فيدخل المسلمون من اليمين إلى مسجدهم، ويدخل النصارى من اليسار إلى كنيستهم، ولما أعاد الوليد بن عبد الملك (86ـ96هـ/705ـ715م) عمارة المسجد سدّ هذا الباب؛ لقربه من قصر الخضراء، وأنشأ عوضه باباً سُمي باب الزيادة، وهو باب الصاغة اليوم. يُنظر: ابن كثير، البداية والنهاية: ج9، ص166؛ ابن بطوطة، الرحلة: ص66؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص413؛ عبد محمّد إبراهيم الكربولي، الجامع الأموي في دمشق وأثره في الحياة السياسية والإدارية والفكرية منذ التأسيس حتى سنة 569هـ/1173م: ص18. ويُنظر: مخطط رقم(9): ص477.
[1022] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص130؛ المقدسي، البدء والتاريخ: ج5، ص12؛ عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص361.
[1023] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص361.
[1024] فخر الدين الطريحي، المنتخب: ج2، ص470.
[1025] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص67.
[1026] الباعوني الشافعي، جواهر المطالب: ج1، ص15؛ الآلوسي، التفسير: ج26، ص72؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص615.
[1027] لمزيد من التفاصيل عن حياة أبي طالب بن عبد المطّلب يُنظر: علي صالح، أبو طالب بن عبد المطّلب دراسة في سيرته الشخصية وموقفه من الدعوة الإسلامية: ص1ـ145.
[1028] ثنية العقاب، الثنية، الطريق العالي من الجبل. وثنية العقاب بالضم، هي المطلّة على غوطة دمشق، يمرّ بها القاصد من دمشق إلى حمص. وقيل: إنّ سبب تسميّتها بثنية العقاب، العقاب من الطير، كان ساقطاً عليها بعشّه وفراخه. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص85؛ الزبيدي، تاج العروس: ج19، ص247؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج1، ص77.
[1029] منظرة: موضع في رأس الجبل، وفيه رقيب يحرس أصحابه من العدو. الفراهيدي، العين: ج8، ص156.
[1030] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص331؛ الباعوني الشافعي، جواهر المطالب: ج1، ص15. وجيرون، بفتح الاول وسكون الثاني بعده راء مهملة، وهي مدينة دمشق، قيل: قد نزل جيرون بن سعد بن عاد دمشق، وبنى مدينتها، وسُمّيت باسمه، وهي إرم ذات العماد. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص199؛ الحميري، الروض المعطار: ص186.
[1031] سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص331. وبألفاظ أخرى يُنظر: الباعوني الشافعي، جواهر المطالب: ج1، ص15؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص615.
[1032] محمّد كاظم القزويني، زينب الكبرى من المهد إلى اللحد: ص377؛ باقر شريف القرشي، السيّدة زينب: ص265.
[1033] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص77؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص101؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص127؛ محسن الأمين، لواعج الاشجان: ص218.
[1034] هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة المدني الانصاري الساعدي، خزرجي، وكنيته أبو العباس، وقيل: أبو يحيى، تُوفي النبي وله من العمر خمس عشرة سنة، وعند إسلامه غيّر النبي اسمه من حزن إلى سهل، وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب×، وشهد له بحديث الغدير في سبعة عشر رجلاً، واستشهد به الحسين في خطبته يوم الطفّ، عن حديث النبي بان الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، وقد عمّر حتى أدرك الحجّاج بن يوسف الثقفي(75ـ95هـ/695ـ714 م) والي العراق الأموي، وفي سنة 74هـ أرسل الحجّاج إليه يريد إذلاله فقال له: ما منعك من نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قال: قد فعلته، قال: كذبت، ثمّ أمر به فختم في عنقه وعنق أنس بن مالك وفي يد جابر بن عبد الله الانصاري؛ يريد بذلك اذلالهم، وأن يستَلِبَّهم النّاس ولا يسمعوا لهم. وقد التقى سهل ٌ عليَ بن الحسين(السجّاد) في دمشق عند وصول سبايا آل البيت، واختلف في وفاته، فقيل في سنة 88هـ/706م، وقيل: في سنة 91هـ/709م، وقيل: سنة 96هـ/714م، وقيل: انه آخر من توفي من الصحابة في المدينة. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج1، ص510؛ البخاري، التاريخ الكبير: ج4، ص97؛ ابن حبان، الثقات: ج3، ص168؛ مشاهير علماء الأمصار: ص48؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج2، ص95؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج2، ص366؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج2، ص88.
[1035] باب الخيزران، لم نعثر على تعريف له. وربما سُمّي بهذا الاسم لوجود عدد من الصنّاع الذين يمتهنون العمل بأعواد الخيزران قرب هذا الباب، لذلك أُطلِق عليه باب الخيزران. لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص430.
[1036]على الرغم من إشارة المصادر إلى أنّ الشمر قال هذا، إلّا أنّنا نستبعد ذلك؛ لما عُرِف عن الشمر من واقعه التطبيقي.
[1037] قشعم الجعفي، لم نعثر على ترجمة له في المصادر التي بين أيدينا.
[1038] مقتل الحسين: ص130ـ131.
[1039] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص358.
[1040] الشعبي، هو عامر بن شراحيل بن عبد، وكنيته أبو عمرو، وهو من حمير وعداده في همدان، تابعي من أهل الكوفة، أدرك مائة وخمسين صحابياً، وروى عنه النّاس، وكان فقيهاً شاعراً، وُلِد سنة 20هـ/640م، وقيل: سنة 21هـ/641م، تُوفي سنة 105هـ/723م، وقيل: سنة 109هـ/ 727م. ابن سعد، الطبقات: ج6، ص259؛ ابن حبان، الثقات: ج5، ص185؛ مشاهير علماء الأمصار: ج1، ص163؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج17، ص359.
[1041] ثعلبة بن مرّة الكلبي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1042] نمير بن أبي جوشن الضبابي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1043] أنيس بن الحرث البعجي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1044] مرّة بن قيس الهمداني، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1045] جابر السعدي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1046] محمّد بن الاشعث الكندي، بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الأكرمين ابن الحارث بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندي بن غفير، أمّه أمّ فروة بنت أبي قحافة، قُتِل سنة 67 هـ. ابن سعد، الطبقات: ج5، ص48؛ ابن حبان، مشاهير علماء الأمصار: ص166؛ ابن منده العبدي، فتح الباب: ص23.
[1047] عمير بن شجاع الكندي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1048] قيس بن أبي مرّة الخزاعي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1049] حواش بن خولي بن يزيد الأصبحي، لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1050] الدربندي، إكسير العبادات: ج3، ص475ـ476.
[1051] سهل بن سعيد الشهرزوري، لم نعثر على ترجمة له في المصادر التي بين أيدينا. ونعتقد أنّ هذا خلط مع اسم سهل بن سعد الساعدي، والمقصود به الأخير.
[1052] مقتل الحسين: ص131ـ132.
[1053] باب الساعات، كانت التسميّة تُطلق على باب الجامع الأموي الجنوبي، ثمّ انتقلت إلى بابه الشرقي. قتيبة الشهابي، معجم دمشق التاريخي: ج1، ص25.
[1054] الحقة، هي سفط، أو سلّة مستديرة مغشاة بالجلد، يجعل فيها الطيب والعطر والثياب والحُلي. ابن أبي شيبه الكوفي، المصنف: ج7، ص439.
[1055] مقتل الحسين×: ج2، ص67ـ68.
[1056] الورق، هو الدرهم. ابن منظور، لسان العرب: ج10، ص375؛ الزبيدي، تاج العروس: ج13، ص478.
[1057] مقتل الحسين: ص131ـ132.
[1058] موسوعة كربلاء: ج2، ص422.
[1059] الإسراء: آية26.
[1060] الإسراء: آية26.
[1061] الأحزاب: آية33.
[1062] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص130؛ الصدوق، الأمالي: ص203؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ج1، ص191؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص34؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص102.
[1063] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص352؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج57، ص98.
[1064] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص130؛ الصدوق، الأمالي: ص203؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص34؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص102؛ باقر شريف القريشي، حياة الإمام الحسين ×: ج3، ص371.
[1065] البهائي، حسبن بن عبد الصمد: كامل البهائي: ج2، ص362.
[1066] عن هذه السياسة الأموية العدائية ضد الإمام علي بن أبي طالب× يُنظر: علي رحيم، السياسة الأموية المضادة للإمام علي× دراسة في سياسة السبّ: ص36ـ115.
[1067] ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص212؛ ترجمة الإمام الحسين× من القسم غير المطبوع: ص81؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354.
[1068] هي هند بنت عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس العبشمية القرشية، وقيل: إنّ اسمها فاختة بنت عبد الله بن عامر، وتُكنّى أمّ كلثوم، وهي زوجة يزيد بن معاوية وأمّ ابنته عاتكة، ولمّا قُتِل الحسين بن علي أكبرت قتله وأقامت عليه المناحة. يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج70، ص4، 166. تفاصيل أوسع يُنظر: صبيح نوري خلف، نساء البيت الأموي: ص218.
[1069] هو الصياح مع البكاء، والمعول عليه، الذي يبكى عليه من الموتى. الثعالبي، فقه اللغة وسرّ العربية: ص107؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج3، ص321.
[1070] هو حزن المرأة عند موت زوجها، ولبس ثياب الحزن وترك الزينة. الزمخشري، أساس البلاغة: ص158 ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج1، ص352.
[1071] هو الصريح من الرجال، المحض الحسب. الفراهيدي، العين: ج3، ص115؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج3، ص347.
[1072] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص219؛ صبيح نوري خلف، نساء البيت الأموي: ص218.
[1073] سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص333؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج4، ص27.
[1074] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص132؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج4، ص353؛ الراوندي، الخرائج والجرائح: ج2، ص581؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص341؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص90؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص333.
[1075] ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج5، ص131.
[1076] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص83؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص332؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص104؛ فخر الدين الطريحي، المنتخب: ص473؛ جعفر عباس الحائري، بلاغة الإمام علي ابن الحسين: ص251.
[1077] فخر الدين الطريحي، المنتخب: ص473؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص457.
[1078] أي أبعد. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج1، ص181؛ الرازي، مختار الصحاح: ص226.
[1079] جمعه الحتوف، الموت، ومات فلان حتف أنفه، إذا مات من غير قتل. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج9، ص38؛ الرازي، مختار الصحاح: ص72.
[1080] القضية أي الموت. يُنظر: ابن سيده، المخصّص: ج2، ص122؛ الزمخشري، أساس البلاغة: ص775.
[1081] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص121؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص69؛ الطبرسي، أعلام الورى: ج1، ص475؛ الاحتجاج: ج2، ص38؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص335.
[1082] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص353؛ الصدوق، الأمالي: ص231؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص343؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص211.
[1083] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص104.
[1084] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص217؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص86؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص470؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ج2، ص836.
[1085] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص362.
[1086] عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وأمّها فاختة بنت عبد الله بن عامر بن كريز، وكنيتها أمّ كلثوم، أمّ البنين الأموية، وهي زوج عبد الملك بن مروان، وأمّ يزيد بن عبد الملك، وإليها تنسب أرض عاتكة، خارج باب الجابية، وكان لها بها قصر، وبه مات عبد الملك بن مروان. يُنظر: ابن حبان، الثقات: ج2، ص319؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج 57، ص310.
[1087] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص214.
[1088] سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ج3، ص92.
[1089] يقصد به الفم، أو الاسنان كلها. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص103؛ الزبيدي، تاج العروس: ج6، ص146.
[1090] هو أبو يزيد الحصين بن الحمام بن ربيعة بن مساب بن حرام المري... إلى أن يصل في نسبه إلى مضر بن نزار، وهو سيد بني سهم بن مرّة، وأمّه صرقلة بنت ضيم بن عوف وترجع إلى قضاعة، وكان يُقال له مانع الضيم. يُنظر: أبو القاسم الحسن، المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء: ج1، ص114؛ ابن حزم، جمهرة أنساب العرب: ج1، ص254؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج13، ص57؛ رزق الله بن يوسف، شعراء النصرانية: ج5، ص733.
[1091] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص356؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج65، ص396؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج5، ص381؛ الكامل: ج4، ص85.
[1092] هو يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس، وكنيته أبو مروان، وهو أخو مروان ابن الحكم، سكن دمشق، ولّاه ابن أخيه عبد الملك بن مروان المدينة المنورة عام 76هـ/695م لمدة قصيرة، بعد نقل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق، ثمّ تولّى حمص، ولم تُعرف السنة التي تُوفي فيها. ابن سعد، الطبقات: ج5، ص252؛ خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص229؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص40؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج64، ص119؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص149.
[1093] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص119؛ ابن شهر آشوب، مناقب: ج3، ص260؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص131.
[1094] آل عمران: آية26.
[1095] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص129؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص64؛ الطبطبائي، تفسير الميزان: ج3، ص142.
[1096] يُسمّى القنا أسلاً؛ تشبيهاً لطوله واستوائه، وتُسمّى الرماح أسلاً؛ لطولها. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج7، ص301؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص104.
[1097] أي ذهاب اليد. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج6، ص218؛ الجوهري، الصحاح: ج5، ص1737.
[1098] بكسر المعجمة وسكون النون وفتح الدال، بعدها فاء، مشيةٌ كالهرولة للرجال والنساء، وصار لقباً اشتهرت به ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة، زوجة الياس بن مضر، لمشيتها مهرولة، واشتهر بنوها بنسبتهم اليها دون أبيهم، لان الياس لما مات حزنت عليه حزناً شديداً، حيث هجرت اهلها ودارها وهامت على وجهها حتى ماتت. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج4، ص335؛ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري: ج6، ص399.
[1099] أبو مخنف، مقتل الحسين: ص133.
[1100] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج8، ص188؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص191؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص34؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص65ـ66؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص331؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105؛ الإربلي، كشف الغمّة: ج2، ص230؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص245.
[1101] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ج1، ص163؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص132؛ محسن الأمين، لواعج الاشجان: ص225.
[1102] الطبرسي الاحتجاج: ج2، ص34؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص212؛ محسن الأمين، لواعج الاشجان: ص222.
[1103] سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ج3، ص92؛ محمّد أمين الأميني، مع الركب الحسيني: ج6، ص154.
[1104] عن وصية الإمام الحسين بن علي÷ لأخته السيّدة زينب في ليل العاشر من المحرّم. يُنظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص244؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص319؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص94؛ ابن مسكويه، تجارب الأمم: ج2، ص75؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص338.
[1105] أُحد، وهو جبل وقعت عنده معركة بين المسلمين والمشركين عام 3هـ/624م، وكان النصر فيها للمشركين. يُنظر: الواقدي، المغازي: ج1، ص199؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص187.
[1106] الأحزاب، معركة وقعت بين المسلمين والمشركين عام 5هـ/626م، وتُسمّى معركة الخندق أيضاً؛ لأنّ المسلمين قد حفروا خندقاً حول المدينة المنورة ليمنعوا المشركين من دخول المدينة، وكان النصر للمسلمين. يُنظر: الواقدي، المغازي: ج1، ص440.
[1107] الفتوح: ج5، ص132؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص71؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص136؛ محسن الأمين، لواعج الاشجان: ص225.
[1108] لا بدّ من التنويه هنا إلى أنّ خطبة السيّدة زينب بنت علي بن أبي طالب‘ في مجلس يزيد قد نقلها كثير من المؤرِّخين بألفاظ مختلفة، إلّا أنّها لا تختلف في معناها. يُنظر: ابن طيفور، بلاغات النساء: ص21ـ23؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص35ـ37؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية: ج6، ص263ـ264؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص80ـ81؛ حميد بن أحمد الحلّي، الحدائق الوردية في مناقب أئمّة الزيدية: ج1، ص218ـ220؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص105ـ 108.
[1109] هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، وأمّه عاتكة بنت عبد الله بن عمير ابن وهيب، وهو شاعر، كان يهجو أصحاب الرسول، ويحرّض بشعره المشركين على المسلمين، ويهجو الشعراء المسلمين أمثال شاعر الرسول’ حسّان بن ثابت، ويسير مع قريش حيث سارت في حربها مع الرسول. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج1، ص391؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج17، ص90؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج6، ص589؛ محمّد أحمد درنيقة، معجم شعراء المدح النبوي: ج1، ص204.
[1110] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص130؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية: ج1، ص262؛ الراوندي، الخرائج والجرائح: ج2، ص581؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج3، ص260.
[1111] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص130.
[1112] يُنظر: ملحق رقم(2): ص467-469.
[1113] باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج3، ص380.
[1114] فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج1، ص232؛ الزبيدي، تاج العروس: ج1، ص176.
[1115] الظن، معروف، وقد يُوضَع موضع العلم، والظنّ يدلّ على معنيينِ مختلفينِ، يقين وشك. الجوهري، الصحاح: ج6، ص2160؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج3، ص462.
[1116] أقطار، ومفردها قطر، الناحية، وجمعها النواحي والأطراف. الفراهيدي، العين: ج5، ص95؛ الحربي، غريب الحديث: ج3، ص972.
[1117] آفاق، ومفردها أفق، أي الناحية، وجمعها نواحي. يُنظر: فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج5، ص135؛ الزبيدي، تاج العروس: ج13، ص6.
[1118] الأسارى، ومفرده الأسير، أي المسجون، ويُقال: إنّ فلاناّ أسر فلاناّ، أي شدّه وثاقاً. الفراهيدي، العين: ج7، ص293؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص19.
[1119] لمزيد من التفاصيل عن مصطلح الطلقاء ومفهومه وأحداثه يُنظر: فاطمة عبد سعيد، الطلقاء دراسة في المعنى وإشكالية القراءة التاريخية: ص7ـ79.
[1120] الذلّ والخزي. ابن منظور، لسان العرب: ج13، ص438؛ الزبيدي، تاج العروس: ج18، ص591.
[1121] أي العزّة والمنزلة الرفيعة. يُنظر: فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج6، ص153؛ الزبيدي، تاج العروس: ج17، ص613.
[1122] أي علوّ المنزلة. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج4، ص213؛ الجوهري، الصحاح: ج2، ص648.
[1123] أي رفع الانف عزاً وتكبّراً. يُنظر: ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج1، ص146؛ ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص327.
[1124] نظرت في عطفك، العطف بكسر العين، هو جانب البدن، والإنسان المعجب بنفسه، ينظر إلى جسمه وملابسه بنوع من الأنانية وحبّ الذات والغرور. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج3، ص176.
[1125] أي الفرح. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج6، ص94؛ الجوهري، الصحاح: ج4، ص1654.
[1126] مستوسقة، مجتمعة. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج5، ص185.
[1127] متّسقة، منتظمة، أي كما تريد. الفراهيدي، العين: ج5، ص81؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج5، ص246.
[1128] صفا، تصافينا، اصطفيته، أخترته. الفراهيدي، العين: ج7، ص163؛ الجوهري، الصحاح: ج6، ص2402.
[1129] الفراهيدي، العين: ج4، ص57؛ ابن منظور، لسان العرب: ج11، ص633.
[1130] آل عمران: آية178.
[1131] الفراهيدي، العين: ج8، ص345؛ ابن منظور، لسان العرب: ج15، ص291.
[1132] فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج1، ص89.
[1133] الطلقاء، ومفردها طليق، وهو الأسير الذي فُكَّ عنه أسره وأُطلِق سراحه. الفراهيدي، العين: ج5، ص102؛ ابن منظور، لسان العرب: ج10، ص227.
[1134] الخدر، يُقال خدر البنت، الزامها الخدر، أي اقامها وراء الستر. الزمخشري، أساس البلاغة: ص217؛ الرازي، مختار الصحاح: ص96.
[1135] الحرائر، ومفردها حرّة، وهي نقيض الأمة ذات العبودية. ابن قتيبة، غريب الحديث: ج2، ص81؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص181.
[1136] إماء، ومفردها أمة، وهي المرأة ذات العبودية. الفراهيدي، العين: ج8، ص431.
[1137] سَوق، يُقال ساق الماشية، حثّها على المسير من الخلف. يُنظر: الزبيدي، تاج العروس: ج13، ص231.
[1138] هتكت، الهتك أن تجذب ستراً، وتشقّ منه طائفة وتقطعه، فيبدو ما وراءه منه. الفراهيدي، العين: ج3، ص374؛ الزبيدي، تاج العروس: ج13، ص668.
[1139] ستور، ومفردها ستر، والمرأة الستيرة، ذات ستارة، وسترة ما أستترت به، والسترة، ما سُتِر الوجه به. الفراهيدي، العين: ج7، ص236؛ الزبيدي، تاج العروس: ج6، ص495.
[1140] أي يحدي الإبل ويسوقها، زاجراً لها من الخلف، ومغنّياً لها. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج6، ص2309؛ ابن منظور، لسان العرب: ج14، ص168.
[1141] يستشرف، رفع الرأس للنظر إلى شيء. الفراهيدي، العين: ج6، ص253؛ التفتازاني، مختصر المعاني: ص35.
[1142] المناهل، ومفرده منهل، وهو موضع الماء الذي ينزل عنده المسافرون للتزود منه. الفراهيدي، العين: ج4، ص51؛ ابن سيده، المخصّص: ج2، ص97.
[1143] المناقل، ومفردها منقل، وهو الطريق عبر الجبال. الفراهيدي، العين: ج5، ص163؛ ابن منظور، لسان العرب: ج15، ص10.
[1144] يتصفّح، يتأمل. الزبيدي، تاج العروس: ج4، ص122.
[1145] الدني، ويقصد به الرجل الخفيف، الحقير، وجمعه أدنياء. ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص78؛ الزبيدي، تاج العروس: ج1، ص154.
[1146] ابن منظور، لسان العرب: ج15، ص406؛ الزبيدي، تاج العروس: ج20، ص311.
[1147] حمي، الدفع عن شيء، ورجل حمي، لا يحتمل الضيم. الفراهيدي، العين: ج3، ص312؛ الجوهري، الصحاح: ج6، ص2319.
[1148] الواقدي، المغازي: ج1، ص121.
[1149] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص337؛ البيهقي، السنن الكبرى: ج9، ص118؛ ابن عبد البر، الاستذكار: ج5، ص152؛ ابن كثير، السيرة النبوية: ج3، ص570.
[1150] ترجى، رجو، الرجا، نقيض الياس، وهو الأمل. الفراهيدي، العين: ج6، ص176؛ الزبيدي، تاج العروس ج19، ص447.
[1151] المراقبة، وهي رقب الله في أمره، أي أخافته. الجوهري، الصحاح: ج1، ص137؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج2، ص427.
[1152] لفظ، هو أن ترمي بشيء كان في فيك. ابن منظور، لسان العرب: ج7، ص461؛ الزبيدي، تاج العروس: ج1، ص492.
[1153] فوه، الفم أصله فوه، والجمع أفواه، والفعل فاه يفوه فوها، إذا فتح فمه للكلام. الفراهيدي، العين: ج1، ص50؛ ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص459.
[1154] النبت، الحشيش، والنبات فعله، ويجري مجرى اسمه، ترى الفتى ينبت إنبات الشجر. الفراهيدي، العين: ج8 ص129؛ الزبيدي، تاج العروس: ج3، ص142.
[1155] هو حمزة بن عبد المطّلب بن عبد مناف، عم الرسول، وأمّه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وكنيته أبوعمارة، وقيل: أبو يعلى، شهد مع الرسول’ معركة بدر، وقُتِل في معركة أُحد. يُنظر: الطبراني، المعجم الكبير: ج3، ص137؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج1، ص369.
[1156] هي هند بنت عتبة بن عبد شمس، العبشمية القرشية الكنانية، وهي إحدى نساء العرب اللائي كانت لهنّ شهرة قبل الإسلام وفي ظله، وزوجها أبو سفيان صخر بن حرب، وولدها معاوية أبو يزيد، وأبوها عتبة بن ربيعة، من سادات قريش وكنانة، وقد قُتل مع المشركين في معركة بدر، وكانت تقدّم المشورة لابنها معاوية في الحكم والسياسة. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج8، ص235؛ الطبراني، المعجم الكبير: ج25، ص69؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج4، ص81؛ العيني، عمدة القري: ج16، ص284؛ صبيح نوري خلف، نساء البيت الأموي ودورهنّ في الحياة الاجتماعية والسياسية حتى نهاية العصر الأموي: ص181.
[1157] الواقدي، المغازي: ج1، ص286؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج15، ص131؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج1، ص372؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج2، ص47.
[1158] ابن هشام، السيرة: ج2، ص456؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص148؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج4، ص388؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج3، ص107؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج2، ص125.
[1159] يستبطأ، بطأ، البطء، والابطاء، نقيض الاسراع. ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص34؛ الجوهري، الصحاح: ج1، ص36.
[1160] الشنف، البغض والتنكّر. الفراهيدي، العين: ج9، ص183؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج5، ص76.
[1161] الشنئان، شدّة البغض. الالبيري المالكي، تفسير القرآن العزيز: ج2، ص7؛ الآلوسي، التفسير: ج6، ص83.
[1162] الإحن، الحقد في الصدر. ابن منظور، لسان العرب: ج13، ص8.
[1163] الاضغان، الضغن والضغينة، الحقد الشديد، والعداوة والبغضاء. الفراهيدي، العين: ج4، ص366؛ ابن منظور، لسان العرب: ج13، ص255.
[1164] متأثّم، تأثم، تحرّج عن الأثم وكفّ عنه، أي تاب عنه واستغفر منه. الجوهري، الصحاح: ج5، ص1858؛ الزبيدي، تاج العروس: ج16، ص6.
[1165] مستعظم، العظم خلاف الصغر، كبر، وهو عظيم، وعظمٌ وعظمة الامر، كفره، وأعظمه وأستعظم، رآه عظيماً. ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص410.
[1166] ثنايا، ومفردها ثنية، وهي الأسنان الأربعة في مقدّمة الفم، اثنتان من فوق واثنتان من تحت. فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج1، ص77.
[1167] تنكت، نكت الأرض بالقضيب، أي التأثير فيها بعد ضربها. الفراهيدي، العين: ج5، ص339؛ الجوهري، الصحاح: ج1، ص269.
[1168] مخصرة، هي العصا، التي في أسفلها، قطعة من الحديد، حادّة تشبه رأس السهم. الفراهيدي، العين: ج4، ص183؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص242.
[1169] نكأ، قشرها بعد أن كادت أن تبرأ. الفراهيدي، العين: ج5، ص412؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص173.
[1170] القرحة، مصدر قرحته، إذا جرحته. ابن السكّيت، ترتيب إصلاح المنطق: ص303؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج2، ص403.
[1171] استأصلت، أي أزلته من أصله. الفراهيدي، العين: ج7، ص156.
[1172] الشأفة، قرحة تخرج في أسفل القدم، وتذهب عند كويها، والشأفة ورم. ابن منظور، لسان العرب: ج9، ص167؛ الزبيدي، تاج العروس: ج12، ص293.
[1173] أتهتف، هتف يهتف هتافاً، الصوت الشديد العالي. الفراهيدي، العين: ج4، ص34.
[1174] الشلل، تعطّل أو تيبّس في حركة عضو من أعضاء الجسم، أو وظيفته، أو قطعها. الفراهيدي، العين: ج6، ص218؛ الجوهري، الصحاح: ج5، ص1737.
[1175] بكمت، الأبكم، الأخرس. بن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج1، ص150؛ ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص53.
[1176] انتقم، انتصر. ابن منظور، لسان العرب: ج5، ص210؛ الزبيدي، تاج العروس: ج7، ص531.
[1177] احلل، تحل، وجب. الفراهيدي، العين: ج3، ص28.
[1178] سفك، سفك الدماء، سفكت العين الدم، أي هدرته. الجوهري، الصحاح: ج4، ص1590.
[1179] فريت، دقت وفتت وقطعت. الفراهيدي، العين: ج8، ص280؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج4، ص497.
[1180] الجزر، القطع، وتستعمل هذه المفردة في نحر البعير وتقطيع لحمه. الفراهيدي، العين: ج6، ص62؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج3، ص245.
[1181] انتهاك، انتهكت حرمة فلان، أي تناولتها بما لا يحب. الفراهيدي، العين: ج3، ص379؛ الجوهري، الصحاح: ج4، ص1613.
[1182] الحرمة، أهل الرجل. ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص125؛ الرازي، مختار الصحاح: ص77.
[1183] اللحمة، القرابة، ويُقال بينهما لحمة نسب. الفراهيدي، العين: ج3، ص246.
[1184] العترة، ولد الرجل من ذريّته، وعقبه من صلبه. الزبيدي، تاج العروس: ج7، ص186.
[1185] يخاصمك، أي خصيمك الذي يخاصمك، من الخصومة، والجمع خصماء. الفراهيدي، العين: ج4، ص191؛ ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص180.
[1186] شملهم، شملة تشملك، أي دفعك، وشمل القوم، أجتمع أمنهم وعددهم. ابن منظور، لسان العرب: ج11، ص370؛ الزبيدي، تاج العروس: ج14، ص393.
[1187] شعثهم، ما تفرّق من الأمور أو الأفراد. الجوهري، الصحاح: ج1، ص285؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج2، ص256.
[1188] آل عمران: آية169.
[1189] حسبك، كفاك. الفراهيدي، العين: ج3، ص149.
[1190] ظهيراً، الظهير: العون، والمظاهر، المعاون. الفراهيدي، العين: ج4، ص37؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص525.
[1191] سوّل، سوّلت لفلان نفسه أمراً، وسوّل له الشيطان، أي زين له، وأراه إيّاه. الفراهيدي، العين: ج7، ص298؛ الجوهري، الصحاح: ج5، ص1733.
[1192] مكّن، التمكين من الشيء. الجوهري، الصحاح: ج6، ص2205؛ ابن منظور، لسان العرب: ج13، ص414.
[1193] وقد أُخِذ هذا النصّ من هذه الآية الكريمة: (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) (الكهف: آية50).
[1194] وقد أُخِذ هذا النصّ من هذه الآية الكريمة: (قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا) (مريم: آية75).
[1195] مريم: آية75.
[1196] الدواهي، مفردها داهية، النائبة والنازلة العظيمة. فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج1، ص152؛ الزبيدي، تاج العروس: ج19، ص423.
[1197] أستصغر قدرك، أستصغر، أستصغره، أعدّه صغيراً. الرازي، مختار الصحاح: ص192؛ الجوهري، الصحاح: ج2، ص713. القدر، مبلغ الشيء. الفراهيدي، العين: ج5، ص113؛ الزبيدي، تاج العروس: ج7، ص370.
[1198] التقريع، الضرب مع العنف والإيلام. الرازي، مختار الصحاح: ص274؛ الزبيدي، تاج العروس: ج11، ص363.
[1199] أستكبر توبيخك، أستكبر، التعظّم. الجوهري، الصحاح: ج2، ص802؛ ابن منظور، لسان العرب: ج5، ص129. التوبيخ، الملامة والتهديد. الفراهيدي، العين: ج4، ص315؛ الجوهري، الصحاح: ج1، ص434.
[1200] العيون عبرى، مغرورقة ومليئة بالدموع. الفراهيدي، العين: ج2، ص130؛ ابن سيده، المخصّص: ج1، ص125.
[1201] الصدور حرّى، ملتهبة من الحزن والاسى. الفراهيدي، العين: ج3، ص23؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص177.
[1202] النجباء، ومفردها نجيب، وهو الفاضل السخي الكريم. ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص748؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج1، ص230.
[1203] تنطف، تقطر أو تسيل. ابن منظور، لسان العرب: ج9، ص336؛ الزبيدي، تاج العروس: ج12، ص506.
[1204] تتحلّب، يُقال حلب فلان الشاة أو الناقة، أي أستخرج ما في ضرعها من اللبن، وأستحلب اللبن، أستدرّه. ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص133؛ الرازي، مختار الصحاح: ص85.
[1205] تنتابها العواسل، تنتابها، تأتي إليّها مرّة بعد مرّة، العواسل مفرده عسل وهو الذئب. الفراهيدي، العين: ج1، ص333؛ الجوهري، الصحاح: ج5، ص1765.
[1206] تعفوها، عفا، والعفو من أسماء الله تعالى، وهو تجاوز الذنب، وترك العقاب عليه. ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص586.
[1207] الفراعل مفرده فرعل، ولد الضبع. الفراهيدي، العين: ج2، ص343؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص567.
[1208] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص314؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص93؛ المسعودي، مروج الذهب: ج2، ص57؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص88؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص55.
[1209] مغنماً، الغنيمة، وجمعها مغانم، وقيل المغنم، هو كلّ ما حصل عليه الإنسان من أموال الحرب. ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص446.
[1210] مغرماً، المغرم، المستقلّ بالدين، أو أسير الدين، ويراد به مغرم الذنوب والمعاصي. ابن منظور، لسان العرب ج12، ص436.
[1211] وقد أُخِذ هذا النصّ من الآيات القرآنية الآتية: (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)(آل عمران: آية182)، (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، (الأنفال: آية51)، (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (الحج: آية10).
[1212] المعوّل، عوّلت عليه، أي استعنت به، وصيّرت أمري إليه، ويُقال: عوّل الرجل عليه، أي اعتمد واتكل عليه، واستعان به. الفراهيدي، العين: ج2، ص248؛ الزبيدي، تاج العروس: ج15، ص531.
[1213] الكيد، إرادة مضرّة الغير خفيةً، والحيلة السيئة، والخدعة والمكر. ابن منظور، لسان العرب: ج3، ص133؛ الزبيدي، تاج العروس: ج5، ص231.
[1214] السعي، هو الكسب، وكل عمل من خير أو من شرّ. أبو الحسن علي بن عبد الله القيسي، ايضاح شواهد الايضاح: ج1، ص521.
[1215] ناصب، نصب الشيء أقامه، ونصب بمعنى تعب. الرازي، مختار الصحاح: ص338.
[1216] الجهد، الوصال، الطاقة، وجهد جهداً جدّ، يُقال: طلب حتى وصل إلى الغاية. ابن سيده، المخصّص: ج3، ص118؛ ابن منظور، لسان العرب: ج3، ص133.
[1217] الأمد، الغاية والنهاية. الجوهري، الصحاح: ج2، ص442؛ ابن منظور، لسان العرب: ج3، ص74.
[1218] ترحض، تغسل. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج2، ص331؛ الجوهري، الصحاح: ج3، ص1077.
[1219] الشنار، العيب الذي فيه العار، وقيل: إنّ الشنار هو أقبح العيب والعار. الجوهري، الصحاح: ج2، ص704؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص430.
[1220] فند، الخطأ في القول والرأي، وقيل: الفند هو الكذب. الفراهيدي، العين: ج8، ص49؛ ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج3، ص475.
[1221] العدد، هو كمية من الوحدات، ويختصّ في المتعدّد ذاته، والعدد للتقليل أي معدود، وهو نقيض الكثرة. الفراهيدي، العين: ج1، ص79؛ الجوهري، الصحاح: ج2، ص505.
[1222] بدد، يُقال: بدّه بدّاً، أي فرّقه، وبدّ الشيء فرّقه. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج1، ص276؛ الزبيدي، تاج العروس: ج4، ص343.
[1223] لعنة، إبعاد عن رحمة الله تعالى ومغفرته. الفراهيدي، العين: ج2، ص141؛ ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص191.
[1224] أُخِذ هذا النصّ من الآية الكريمة: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) (هود: آية18).
[1225] خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص194؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص125؛ الكتبي، فوات الوفيات: ج2، ص641؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص259.
[1226] الثواب، هو الجزاء على العمل خيراً أو شرّاً، وأثابه، أي جازاه وكافأه. الجوهري، الصحاح: ج2، ص576؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص10.
[1227] المآب، المرجع. الفراهيدي، العين: ج8، ص417.
[1228] الشرافة، من الشرف، وهو العلو، والمكان العالي. الفراهيدي، العين: ج6، ص258؛ الجوهري، الصحاح: ج4، ص1379.
[1229] أُخِذ هذا النصّ من الآية الكريمة: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)(آل عمران: آية173).
[1230] أُخِذ هذا النصّ من الآية الكريمة، (وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ)(الأنفال: آية40).
[1231] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص220؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص37؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص81؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص108؛ الكتبي، فوات الوفيات: ج2، ص645.
[1232] محمّد أمين الأميني، مع الركب الحسيني: ج6، ص172.
[1233] لقد تباين المؤرِّخون في ذكر خطبة علي بن الحسين، في مجلس يزيد الذي عقد في قصره، فمنهم من ذكرها مفصلة. يُنظر: ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص247؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص76ـ78. ومنهم من ذكر معظمها، يُنظر: ابن شهر آشوب، مناقب: ج4، ص168؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص161. ومنهم من ذكر بعض الفقرات منها. يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص121؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص102؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص19.
[1234] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص132؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص76؛ ابن نما الحلى،مثير الأحزان: ص81؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص109؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص137.
[1235] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص132؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص76؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص137. يُنظر: ملحق رقم(3): ص470.
[1236] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص132؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص76.
[1237] المصدران السابقان.
[1238] زقّ الطير، أي وُضِع الطعام في فمه. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج5، ص13؛ الجوهري، الصحاح: ج4، ص1491.
[1239] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص133؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص76.
[1240] العلم، أي العلم الرباني، الذي لا يوجد عند أحد، وهو علم الكتاب. الفراهيدي، العين: ج3، ص246؛ بن الأثير، النهاية في غريب الحديث: ج1، ص434.
[1241] الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين: ج3، ص126؛ الطبراني، المعجم الكبير: ج11، ص55؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، 1102؛ الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج5، ص110 و ج7، ص182 و ج11، ص50؛ الحسكاني، شواهد التنزيل: ج1، ص434؛ الطبرسي، أعلام الورى: ج1، ص317؛ الطوسي، الثاقب في المناقب: ص130؛ ابن الجوزي، الموضوعات: ج1، ص350؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج7، ص219؛ الحلّي، كشف اليقين: ص51؛ الذهبي، ميزان الاعتدال: ج4، ص366.
[1242] البقرة: آية189.
[1243] سليمان بن إبراهيم القندوزي، ينابيع المودّة: ص205.
[1244] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج1، ص33.
[1245] ابن رستم الطبري، دلائل الإمامة: ص236؛ نوادر المعجزات: ص127؛ ابن حاتم العاملي، الدر النظيم: ص604.
[1246] الكليني، الكافي: ج 1 ص399.
[1247] المصدر السابق؛ الصفار، بصائر الدرجات: ص33.
[1248] الكليني، الكافي: ج 1، ص260.
[1249] هشام بن الحكم، وهو أبو محمّد مولى كندة، نزل في بني شيبان بالكوفة، وانتقل إلى بغداد سنة 199هـ/814 م، وهو من خواصّ أصحاب الصادق والكاظم، وروى عنهما، كان مشهوراً بعلم الكلام، وله كتاب بالإمامة، وعدّة مصنفات أخرى، فمولده بالكوفة، ومنشؤه في واسط، وتجارته في بغداد، سُئل يوماً عن معاوية بن أبي سفيان، أشَهِدَ بَدراً؟ قال: نعم من ذلك الجانب، تُوفي في بغداد، وترحّم عليه الإمام علي بن موسى الرضا×. يُنظر: النجاشي، رجال النجاشي: ص136ـ433؛ الطوسي، رجال الطوسي: ص153ـ329؛ الفهرست: ص258؛ ابن داود، رجال ابن داود: ص200؛ الحلي، خلاصة الأقوال: ص288. وكذلك يُنظر: مخلد ذياب فيصل، هشام بن الحكم الكوفي ودوره في الحياة الفكرية خلال العصر العباسي الأول: ص8ـ131.
[1250] النمل: آية75.
[1251] ابن رستم الطبري، دلائل الإمامة: ص236؛ نوادر المعجزات: ص127.
[1252] الشيخ المفيد، الاختصاص: ص187؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج17، ص158.
[1253] محمّد طاهر بن علي الفتني، تذكرة الموضوعات: ص87؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج2، ص163؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج1، ص371.
[1254] الهلالي، سليم بن قيس: ص256؛ زيد بن علي، مسند زيد بن علي: ص406؛ أبو بكر بن أبي عاصم، الآحاد والمثاني: ج1، ص151.
[1255] الصدوق، الخصال: ص402.
[1256] هي الغزوة التي وقعت بين العرب والروم في سنة 8هـ/629م، في قرية يُقال لها مؤتة، ومؤتة أدنى البلقاء، والبلقاء دون دمشق. يُنظر: الواقدي، المغازي: ج2، ص755؛ ابن هشام، السيرة: ج2، ص377؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج2، ص318؛ عبد الملك النيسابوري، شرف المصطفى: ج3، ص68.
[1257] الهلالي، سليم بن قيس: ص481؛ الطبراني، المعجم الكبير: ج2، ص107؛ الصدوق، الأمالي: ص143؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج1، ص242؛ السرخسي، أصول السرخسي: ج1، ص325؛ الهيثمي، مجمع الزوائد: ج9، ص273؛ المتّقي الهندي، كنز العمال: ج11، ص663.
[1258] ابن جبر، نهج الإيمان: ص159؛ الطوسي، الأمالي: ص258؛ بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص326.
[1259] الهلالي، سليم بن قيس: ص358؛ النعمان المغربي، شرح الأخبار: ج1، ص123؛ محمّد بن سليمان الكوفي، مناقب الإمام أمير المؤمنين: ج2 ص213؛ ابن رستم الطبري، المسترشد: ص580.
[1260] الحسب، الشرف الثابت من الآباء، وقيل هو الشرف في الفعل. الفراهيدي، العين: ج3، ص148؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص310.
[1261] النسب، أي أنتسب إلى أبيه، والنسب، القرابة. الجوهري، الصحاح: ج1، ص224؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص755.
[1262] بيت الله الحرام، وسُمّيت بمكّة؛ لأنّها تمك الجبارين، أي تُذهِب نخوتهم، كما سمّيت بمكة؛ لازدحام النّاس فيها. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص181.
[1263] مِنى، بالكسر والتنوين، وتقع في درج الوادي الذي ينزله الحاج، ويرمي فيه الجمار من الحرم، وسُمّي بذلك لما يُمنى به الدماء، أي تُراق، وقيل: إنّ آدم تمنّى فيها الجنّة. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص198.
[1264] زمزم، بفتح أوله وسكون ثانيه وتكرار الزاي والميم، هي البئر المباركة المشهورة، وقيل: سُمّي بزمزم؛ لكثرة مائها. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص147.
[1265] الصفا، بالفتح والقصر، والصفا والصفوان والصفو، تدلّ على العريض من الحجارة الملساء، ومنها الصفا والمروة، وهما جبلان بين بطحاء مكّة والمسجد الحرام. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص411.
[1266] لقد اختلفت قبائل مكّة عند إعادة بنائها الكعبة، حول من يضع الحجر الأسود في مكانه، واتّفقوا على أن الذي يحكم بينهم أول داخل من باب المسجد، فكان النبي أوّل داخل من باب المسجد ـ وهو في الخامسة والثلاثين من عمره يومذاك ـ فقبلوا به وقالوا: هذا الأمين رضينا به، هذا محمّد، ولمّا عرف النبي بخلافهم قال لهم: هلمّوا إلى ثوب، ولما أتوا به أخذ النبي الحجر ووضعه بيده في وسط الثوب، ثمّ قال: لتأخذ كلّ قبيلة بناحية من الثوب، ورفعوه جميعاً، ولمّا بلغوا موضعه وضعه النبي بيده، ثمّ بني عليه. يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية: ج1، ص124ـ128؛ الكلاعي، الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله: ج1، ص130ـ135؛ ابن سيد النّاس، السيرة النبوية: ج1، ص75ـ79.
[1267] يُراد به الطواف حول الكعبة. الفراهيدي، العين: ج7، ص458.
[1268] المراد منه: السعي، وهو المشي والهرولة ما بين الصفا والمروة. الفراهيدي، العين: ج2، ص202.
[1269] لبّى: أي رفع الصوت بالتلبية، وهي قول: لبّيك اللهمّ لبّيك. الجوهري، الصحاح: ج6، ص2478.
[1270] الدابة التي ركبها الرسول عندما أُسري به إلى بيت المقدس، وكذلك عندما عُرِج به إلى السماء. ابن حنبل، مسند: ج4، ص208؛ ابن كثير، السيرة النبوية: ج1، ص56.
[1271] هو انتقال النبي ليلاً على دابة البراق، من المسجد الحرام في مكّة إلى المسجد الأقصى (بيت المقدس) في فلسطين الحالية، ومنها عرج إلى السماء. يُنظر: ابن هشام، السيرة النبوية: ج2، ص276؛ الطبري، جامع البيان: ج15، ص8؛ ابن حزم، المحلّى: ج2، ص229؛ الغزالي، الإسراء والمعراج: ص7؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج2، ص56؛ ابن كثير، السيرة النبوية: ج1، ص199؛ السيوطي، الدرّ المنثور: ج4، ص149؛ محمّد عبد علي، معجزة الإسراء والمعراج دراسة شرعية: ص442.
[1272] المصطفى، يصطفيه أي يدخل صفوته، أياد أخياره. والصفي، خالص كلّ شيء ومختاره. ابن منظور، لسان العرب: ج6، ص326؛ الزبيدي، تاج العروس: ج19، ص602.
[1273] المرتضى، الرضا خلاف السخط، ورضاؤه بالشيء، أي قبوله. ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج2، ص402؛ الثعلبي، الكشف والبيان: ج4، ص39.
[1274] خراطيم، أنوف. الفراهيدي، العين: ج4، ص333؛ ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص173.
[1275] ابن هشام، السيرة: ج1، ص124؛ الكلاعي، الاكتفاء بما تضمّنه من مغازي رسول الله: ج1، ص130؛ ابن سيد النّاس، السيرة: ج1، ص75.
[1276] الصدوق، الأمالي: ص77؛ ابن رستم الطبري، نوادر المعجزات: ص61؛ عماد الدين الطبري، بشارة المصطفى: ص247.
[1277] الكليني، الكافي: ج5، ص12؛ الصدوق، الخصال: ص267.
[1278] الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى: ج4، ص118.
[1279] المجلسي، بحار الأنوار: ج39، ص341ـ342.
[1280] يُقصد بالهجرتين، هجرة المسلمين إلى الحبشة، وإلى يثرب، والمعلوم أنّ الإمام علي× قد هاجر إلى يثرب، ولم يثبت أنّه هاجر إلى الحبشة، ولعلّه ووفقاً إلى ما أشار إليه عبد الله بن عباس أنّ النبي قد هاجر هجرتين، إحداهما إلى يثرب، وثانيهما إلى الطائف، وبقي بها أيّاماً معدودة، وكان علي× مصاحباً للنبي في هجرته للطائف. يُنظر: البرقي، المحاسن: ج2، ص331؛ النعمان المغربي، شرح الأخبار: ج2، ص392ـ394؛ رحمن حسين علي، الهجرة إلى الحبشة: ص23ـ131.
[1281] ابن هشام، السيرة: ج1، ص212؛ ابن شهر آشوب، مناقب: ج1، ص290؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج2، ص202؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج3، ص72؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج38، ص229؛ هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن: ج2، ص833.
[1282] البرقي، المحاسن: ج2، ص331؛ النعمان المغربي، شرح الأخبار: ج2، ص392.
[1283] البيعتين، أولاهما، بيعة بدر عام 2هـ/623م، وهي بيعة المسلمين للنبي على القتال، وعدم التخلي عنه. ابن هشام، السيرة: ج2، ص447؛ البيهقي، دلائل النبوة: ج3، ص34؛ ابن شهر آشوب، مناقب: ج1، ص290 ابن الجوزي، المنتظم: ج3، ص100؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج38، ص229. وثانيهما، بيعة الرضوان عام 6هـ/627م، وهي البيعة التي بايع فيها المسلمون النبي تحت الشجرة، بعد ان بلغ النبي مقتل عثمان. ابن هشام، السيرة: ج3، ص708؛ النووي، شرح صحيح مسلم: ج12، ص135؛ الشوكاني، نيل الاوطار: ج2، ص329 ابن كثير، السيرة: ج3، ص316؛ السيوطي، كفاية الطالب: ج1، ص244؛ أحمد عبد الغفور عطار، غزوات الرسول: ص97.
[1284] أولاهما قبلة المسجد الاقصى، وهو بيت المقدس، الذي جدّد بناءه النبيّ سليمان بن داود، وسمي بالأقصى لبعده عن مسجد مكّة، أو لكونه لا مسجد وراءه وهي القبلة الاولى، وقد أمر المسلمون بالتوجه اليها في الإسراء والمعراج، وقبل الهجرة بعام. ابن هشام، السيرة: ج1، ص396؛ ابن كثير، قصص الانبياء: ج1، ص304، وثانيهما قبلة المسجد الحرام، الذي بناه النبي إبراهيم في مكّة، وقد حوّلت إليه القبلة، في العام الثاني للهجرة. مالك الموطأ: ج1، ص196؛ ابن هشام، السيرة: ج2، ص276؛ الشافعي، المسند: ص234؛ ابن حنبل، المسند: ج1، ص325؛ البخاري، صحيح: ج1، ص104؛ الطبري، جامع البيان: ج15، ص8.
[1285] ابن هشام، السيرة: ج2، ص447؛ البيهقي، دلائل النبوة: ج3، ص34؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج3، ص100.
[1286] ابن هشام، السيرة: ج3، ص708؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج17، ص227؛ أحمد عبد الغفور عطار، غزوات الرسول: ص97.
[1287] ابن هشام، السيرة: ج1، ص396؛ ابن كثير، قصص الأنبياء: ج1، ص304.
[1288] البقرة: آية144.
[1289] ابن شهر آشوب، مناقب: ج1، ص290؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج38، ص229؛ هاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن: ج2، ص833.
[1290] الواقدي، المغازي: ج2، ص885؛ ابن هشام، السيرة: ج4، ص889.
[1291] المصدران السابقان؛ المقريزي، إمتاع الأسماع: ج8، ص387.
[1292] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج42، ص313؛ الذهبي، ميزان الاعتدال: ج4، ص46؛ سبط بن العجمي، الكشف الحثيث: ص249؛ الحلبي، السيرة الحلبية: ج1، ص435.
[1293] الصدوق، الأمالي: ص83؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص100؛ ابن شهر آشوب، مناقب: ج2، ص274؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج36، ص28.
[1294] ابن طاووس، اليقين: ص427؛ حسن بن سليمان الحلّي، المحتضر: ص255.
[1295] أي ذلّلته فذلّ وأختبأ. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج1، ص188؛ الجوهري، الصحاح: ج3، ص1272.
[1296] الملحدين: الكافرين، وهم من العرب واليهود ممَّن لحدوا في دين الله تعالى ودين رسوله. ابن قتيبة، غريب الحديث: ج1، ص59؛ ابن منظور، لسان العرب: ج3، ص388.
[1297] يعسوب: أمير النحل. ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج4، ص318.
[1298] هو الإكليل الذي يُوضع على الرأس، وتوّجه أي سوّده، فجعله سيّداً. يُنظر: الزبيدي، تاج العروس: ج3، ص305؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج2، ص282.
[1299] الناكثين، ومفرده الناكث، وهو من نقض العهد. ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص197؛ الزبيدي، تاج العروس: ج3، ص273.
[1300] القاسطين، ومفرده قاسط، وهو من يميل عن الحقّ. الفراهيدي، العين: ج5، ص71؛ ابن منظور، لسان العرب: ج7، ص378.
[1301] المارقين: الخارجين من الدين، والمرق، الطعن بالعجلة، وبلغ السهم من الرمية، أي خرج من الجانب الآخر، والممرق هو المغني. ابن منظور، لسان العرب: ج10، ص341؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج5، ص235.
[1302] الناصبين، ناصبت فلاناً، أي بالشرّ والحرب والعداوة ونحوهما، ونصبت بفلان إذا عاديته، ويعني به من يضمر العداوة لآل البيت ويبغضهم، وينسبهم إلى ما يقدح في عدالتهم. الجوهري، الصحاح: ج1، ص225؛ نجم الدين الحلّي، المعتبر: ج2، ص766.
[1303] قاصم، أي دقّ الشيء. الفراهيدي، العين: ج5، ص70؛ ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص485.
[1304] مبير، مهلك يسرف في إهلاك النّاس، يبور بوراً فهو مبير، ودار البوار، دار الهلاك، والبوار، الكساد. ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص86.
[1305] بلاغة الإمام علي بن الحسين÷، تحقيق جعفر عباس الحائري: ص98.
[1306] فرات الكوفي، تفسير: ص464؛ الصدوق، الأمالي: ص274؛ الطوسي، الأمالي: ص607؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص115.
[1307] عيبة، موضع السّرّ عند الرجل، والذين يأتمنهم على أمره. الفراهيدي، العين: ج2، ص264.
[1308] سمح، أي كثير السماح. الفراهيدي، العين: ج3، ص155؛ ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص489.
[1309] سخيّ، كثير الكرم والجود. الفراهيدي، العين: ج4، ص289؛ الجوهري، الصحاح: ج6، ص2373.
[1310] بهلول، أي الضحّاك. ابن منظور، لسان العرب: ج11، ص73؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج3، ص339.
[1311] زكي، الطاهر من الأخلاق الذميمة. الفراهيدي، العين: ج5، ص394؛ الرازي، مختار الصحاح: ص148.
[1312] أبطحي، نسبة إلى البطائح، ومفردها بطحاء، وهي بطائح مكّة، ويُقال لقريش الداخلة في البطاح، وهم الذين ينزلون الشعب بين أخشبي مكّة. الفراهيدي، العين: ج3، ص175؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص444؛ ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص413.
[1313] رضي مرضي، أي راضٍ بما قسم الله تعالى له، والله راضٍ عنه. الثعلبي، الكشف والبيان: ج4، ص39؛ المقري، المصباح المنير: ج1، ص229.
[1314] مقدام، أي متقدّم على رأس الجيش. ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص468؛ الزبيدي، تاج العروس: ج1، ص124.
[1315] همام، أي عظيم الهمّة. ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص621؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص192.
[1316] قمقام، السيّد كثير الخير. الفراهيدي، العين: ج7، ص172.
[1317] الأصلاب، ومفرده صلب، وهو كلّ شيء من الظهر. الفراهيدي، العين: ج7، ص127؛ الجوهري، الصحاح: ج1، ص164.
[1318] أربطهم جَناناً، أكثرهم أستقرار القلب من الفزع. الفراهيدي، العين: ج6، ص21؛ ابن منظور، لسان العرب: ج13، ص93.
[1319] أجرأهم لساناً، أي أنّه جريء جسور مقدام. الجوهري، الصحاح: ج6، ص2166؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج4، ص23.
[1320] أمضاهم عزيمة، أي الصبر والحزم، وما عقد القلب على فعله. الفراهيدي، العين: ج1، ص363؛ ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص400.
[1321] الشكيمة، الطبع. يُنظر: الحربي، غريب الحديث: ج2، ص538؛ الجوهري، الصحاح: ج5، ص961.
[1322] عمرو بن ودّ العامري، ويُلقّب ذا الثدية، قُتِل في غزوة الأحزاب وعمره 140 سنة. الواقدي، المغازي: ج1، ص440.
[1323] المصدر السابق.
[1324] باسل، شجاع. الفراهيدي، العين: ج7، ص263؛ ابن قتيبة، غريب الحديث: ج1، ص343.
[1325] هاطل، أي تتابع القطر من السحاب أو الدمع من العين. الفراهيدي، العين: ج4، ص21؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج6، ص56.
[1326] أزدلفت، أي اقتربت أو اجتمعت. الفراهيدي، العين: ج7، ص368؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج5، ص67.
[1327] الأسنّة، ومفردها سنان، أي الرمح. الجوهري، الصحاح: ج5، ص2140؛ ابن سيده، المخصّص: ج4، ص21.
[1328] الأعنّة، ومفردها عنان، الفرس وجمعها خيول. الجوهري، الصحاح: ج6، ص2166؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج4، ص22.
[1329] الهشيم، هو النبات اليابس المتكسّر، الشجرة البالية يأخذها الحاطب كيف يشاء، ورجل هشيم، أي ضعيف البدن. الجوهري، الصحاح: ج5، ص2059.
[1330] ليث، الأسد لقوّته وشدّة أخذه. الجوهري، الصحاح: ج1، ص292؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج5، ص223.
[1331] الحجاز، بالكسر وآخره زاي، وسُمّي حجازاً لأنّه يحتجز بالجبال، والحجاز ما حجز ما بين تهامه والعروض. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص218.
[1332] الإعجاز، أو العجوز، ومفرده العجز، مؤخّر الشيء، والمعجزة واحدة، ومعاجز الأنبياء، واعجاز الأمور أي أواخرها. الفراهيدي، العين: ج1، ص215؛ ابن منظور، لسان العرب: ج5، ص370.
[1333] كبش، وكبش القوم هو سيّدهم. الجوهري، الصحاح: ج3، ص1017.
[1334] المائدة: آية55.
[1335] ابن حنبل، مسند أحمد: ج4، ص281.
[1336] النعمان المغربي، دعائم الإسلام: ج1، ص16؛ محمّد بن جمال الدين المكّي الشهيد الأول، الروضة البهية: ج7، ص148؛ عبد الحسين أحمد الأميني، الغدير: ج1، ص11.
[1337] البرقي، المحاسن: ج2، ص331.
[1338] تهامي، بالكسر، وادي باليمامة. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص63.
[1339] خيفي، الخيف، موضع في مكّة. الفراهيدي، العين: ج4، ص312؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص412.
[1340] من الوغى ليثها، أي في الحروب أسدها. الفراهيدي، العين: ج4، ص457؛ الجوهري، الصحاح: ج6، ص2526.
[1341] المشعرين، أي شعائر الحجّ ومناسكه. ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص414؛ الزبيدي، تاج العروس: ج7، ص33.
[1342] الكتائب، ومفردها الكتيبة، الجيش، أي مفرّق الجيوش. ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص701؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج2، ص94.
[1343] الشهاب، شعلة من النار. الفراهيدي، العين: ج3، ص403؛ ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج3، ص220.
[1344] الثاقب، نجم ينفذ السماوات كلّها. ابن فارس، معجم مقايس اللغة: ج1، ص382؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج2، ص18.
[1345] العاقب، أي آخر الأنبياء أو الرسل. ابن منظور، لسان العرب: ج12، ص164؛ الجوهري، الصحاح: ج1، ص184.
[1346] أسد الله الغالب، وهو الذي يغلب أقرانه فيما يمارس. الفراهيدي، العين: ج4، ص420؛ أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية: ص154.
[1347] مطلوب كلّ طالب، أي الشفيق. الفراهيدي، العين: ج1، ص261؛ ابن منظور، لسان العرب: ج1، ص560.
[1348] بضعة، أي القطعة منه، يُقال أعطيته قطعة من اللحم. ابن منظور، لسان العرب: ج8، ص12.
[1349] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص76ـ78.
[1350] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص144.
[1351] الراوندي، الخرائج والجرائح: ج2، ص754؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص109؛ الصفار، بصائر الدرجات: ج2، ص145.
[1352] الصدوق، الأمالي: ص231؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص81.
[1353] لربما الحديث كان بالنبطية وليس بالقبطية؛ لأنّ الاقباط هم بقايا المصريين القدماء(كبتوز).
[1354] الراوندي، الخرائج والجرائح: ج2، ص754؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص109؛ الصفار، بصائر الدرجات الكبرى: ج 2، ص145.
[1355] الصدوق، الأمالي: ص231؛ الراوندي، الخرائج والجرائح: ج2، ص754؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص81؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص209؛ الصفار، بصائر الدرجات: ج2، ص145.
[1356] لتحويل التقويمين من وإلى الآخر. يُنظر: فريمان جرنفيل، التقويمان: ص23ـ25.
[1357] المنهال بن عمرو، كنيته أبو محمّد، ولقبه الاسدي؛ لأنه مولى لبني عمرو بن أسد بن خزيمة الكوفي، ويُعدّ من أصحاب الإمام الحسين، والإمام علي بن الحسين، والإمام محمّد بن علي الباقر، والإمام جعفر بن محمّد الصادق^، وروى عنهم، وهو من الرواة الثقات. يُنظر: يحيى ابن معين، تاريخ بن معين: ج1، ص299؛ الطوسي، رجال الطوسي: ص105؛ ابن أيوب الباجي، التعديل والتجريح: ج2، ص837؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج60، ص371؛ المزي، تهذيب الكمال: ج28، ص568.
[1358] الأسى، مقصور، الحزن على الشيء. الفراهيدي، العين: ج7، ص332؛ الزبيدي، تاج العروس: ج19، ص157.
[1359] العرى، مقصور، ما ستر شيئاً من شيء. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج4، ص297.
[1360] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص144.
[1361] يستحيون، يبقون، يتركون. ابن منظور، لسان العرب: ج14، ص213؛ الزبيدي، تاج العروس: ج19، ص358.
[1362] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص220؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص120؛ النعمان المغربي، شرح الأخبار: ج2، ص484؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج41، ص396؛ المزي، تهذيب الكمال: ج20، ص399؛ المحسن بن كرامة، تنبيه الغافلين: ص104.
[1363] مثبورون، الثبور، الهلاك والخسران. الجوهري، الصحاح: ج2، ص604؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص401.
[1364] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص133؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص79.
[1365] أبو برزة الأسلمي، هو نضلة بن عبد الله، وقيل: عبيد الله الأسلمي، مشهور بكنيته أبو برزة، من الصحابة، روى عن النبي كثيراً، وشهد فتح خيبر، وفتح مكّة سنة 8هـ/629م، وفتح حنين سنة 8هـ/629م، كان من ساكني المدينة، ثمّ سكن البصرة ومات فيها، وأقام مدّة مع معاوية ابن أبي سفيان، وغزا خراسان، وقيل: إنّه شهد مع الإمام علي× صفّين والنهروان، وقيل: إنّ وفاته في سنة 64هـ/683م، أو سنة 65هـ/684م. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج4، 223؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج4، 24؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج5، ص147؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص40؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج7، ص33.
[1366] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص416؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج6، ص254؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، 129؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ج2، ص835.
[1367] ابن أعثم، الفتوح: ج5، 129؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص63ـ64؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص192.
[1368] عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس، أبو مطرف، ويُقال: أبو حرب، ويُقال: أبو الحارث، أخو مروان بن الحكم، سكن دمشق، وكان شاعراً محسناً. أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج13، ص176؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق : ج34، ص311؛ الكتبي، فوات الوفيات: ج1، ص623؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج18، ص82؛ الزركلي، أعلام: ج3، ص305.
[1369] مقتل الحسين: ص219؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص356؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج62، ص84.
[1370] الأغاني: ج13، ص178؛ ويُنظر: الشجري، الأمالي الخميسية: ج1، ص312.
[1371] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص145.
[1372] الشورى: آية33.
[1373] ابن البطريق، عمدة عيون صحاح الأخبار: ص35؛ ابن جبر، نهج الإيمان: ص83.
[1374]سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص333؛ الخوارزمي، مقتل الحسين× ج2، ص80.
[1375] الخوارزمي، مقتل الحسين× ج2، ص81.
[1376] مسند أبو يعلى ج3، ص170؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج21، ص57.
[1377] الجالوت: اسم رجل اعجمي لا ينصرف، وفي الديانة اليهودية هو منصب ديني يراد به رئيس علماء اليهود. الثعالبي، ثمار القلوب: ص322؛ ابن منظور، لسان العرب: ج2، ص21؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج5 ص344؛ الزبيدي، تاج العروس: ج3، ص32.
[1378] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص136؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج4، ص353؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص90؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص333؛ الراوندي، الخرائج والجرائح: ج2، ص581.
[1379] الحبر: العالم من علماء الدين، وجمعه أحبار. الفراهيدي، العين: ج3، ص218؛ الجوهري، الصحاح: ج2، ص619؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص158.
[1380] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص132.
[1381] المصدر السابق؛ مرتضى العسكري، معالم المدرستين: ج3، ص159.
[1382] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص146.
[1383] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص370.
[1384] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص146.
[1385] ويُقصد بهذا المثل، ليس بغلام أعياني أبوه، بمعنى إذا لم يصلح الوالد لم يصلح الولد. أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال: ج2، ص380.
[1386] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص74؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص78؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص108؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص135.
[1387] ابن قتيبة، الإمامة والسياسة: ص7؛ المسعودي، أثبات الوصية: ص182؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص213.
[1388] ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص160.
[1389] قيس بن الربيع، ويُكّنى أبا محمّد، الأسدي الكوفي، ويُقال له: الحوال؛ لكثرة سماعه وعلمه، وأفسد كتبه ولده، والنّاس يضعفونه، وبعضهم يعدّونه من الثقات، توفي عام 168هـ/784 م. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج6، ص355؛ خليفة بن خياط، طبقات: ص287؛ البخاري، الضعفاء: ص115؛ العجلي، الثقات: ج2، ص220؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج24، ص219.
[1390] الانطاع، وهو بكسر النون وفتح الطاء، ومعناه الجلود ودبغها وصبغها، والنطع ما يُتّخذ من الأدم، ويجمع على أنطاع، والتنطّع في الكلام تعمّق واشتقاق. الفراهيدي، العين: ج2، ص16؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج5، ص440؛ القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة: ج3، ص320.
[1391] الديبق، وهو نوع من الأقمشة الفاخرة، ويُصنع منها المناديل والثياب والعمائم. الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج 1، ص73؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج10، ص195.
[1392] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص146ـ147؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص590ـ591؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص518.
[1393] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص147؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص82.
[1394] ابن سعد، الطبقات: ج5، ص212؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص335.
[1395] الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص122؛ الطبرسي، اعلام الورى: ج1، ص475.
[1396] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص217؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص217؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص355؛ الصدوق، الأمالي: ص231؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص81؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص177؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص86؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص304.
[1397] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص81.
[1398] وهي إحدى دور بني أميّة، تقع عند باب الدرج، شرقي المسجد، واصبحت فيما بعد داراً لخالد ابن يزيد بن معاوية(ت 90هـ/708م). ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج16، ص304.
[1399] هو الجمع والحبس والمنع والتضيق. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج2، ص78؛ الجوهري، الصحاح: ج2، ص630.
[1400] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص370. والإحصاء، عدّ الشيء. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج4، ص29؛ ابن منظور، لسان العرب: ج14، ص183.
[1401] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص462؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص249؛ محمّد مهدي الحائري، معالي السبطين: ص164.
[1402] عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص370.
[1403] ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص85؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص113؛ عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص397؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص144.
[1404] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص217؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص355؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص213.
[1405] ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص85؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص114؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص144.
[1406] هو خالد بن يزيد بن معاوية، ويكنى أبا هاشم الأموي، وأمه أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف، وهو من رجال بني أميّة، وروى من وعن كثيرين، وكان خطيباً وشاعراً محباً للعلم، فاشتغل بالكيمياء والطب والنجوم، وألف فيها رسائل، وأحضر بعض فلاسفة اليونان من مصر، وأمرهم بنقل العلوم اليونانية والقبطية إلى العربية، توفي سنة 90هـ/708م. يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج17، ص219؛ ابن النديم، الفهرست: ص419؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج16، ص301ـ309؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص236؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج7، ص3184؛ ابن حجر العسقلاني، تقريب التهذيب: ج1، ص265؛ الزركلي، الأعلام: ج2، ص301.
[1407] وشنشنة الرجل غريزته وخلقه وطبيعته، وشنشنة أعرفها من أخزم، يضرب مثلاً للرجل الذي يشبه أباه، وابو أخزم هو جد حاتم الطائي، أو جد جده، وبعد موت أخزم، وثب يوماً بنوه على جدهم وأدموه، فقال:
|
إنّ بني رملوني بدم شنشنة أعرفها من أخزم |
والمثل لجدّ حاتم بن عبد الله بن الحشرج بن أخزم، وكان أخزم من أجود النّاس، ولما نشأ حاتم، وفعل من أفعاله الكرم، قال: هي شنشنة أعرفها من أخزم. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج6، ص220؛ ابن سلام، غريب الحديث: ج3، ص241؛ أبو هلال العسكري، جمهرة الأمثال: ج1، ص541.
[1408] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص215؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص261؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص87؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص230؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص471؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص212؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ج2، ص838.
[1409] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص144؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص82؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص84.
[1410] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص82.
[1411] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص214؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص261؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص353؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص344؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج6، ص2632.
[1412] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص122؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص82.
[1413] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص215؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص122؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص192؛ الطبرسي، أعلام الورى: ج1، ص476؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص88؛ عماد الدين الطبري، كامل البهائي: ج2، ص371.
[1414] ابن سعد، ترجمة الإمام الحسين× ومقتله، من القسم غير المطبوع من كتاب الطبقات الكبير: ص84؛ محمّد باقر المحمودي، ترجمة الإمام الحسين من تاريخ مدينة دمشق: ص325.
[1415] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص215؛ ابن سعد، الطبقات: ج5، ص212؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص261؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص354؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ج2، ص122؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص82؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص192؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص88؛ الطبرسي، أعلام الورى: ج1، ص476؛ ابن العديم، بغية الطلب في تاريخ حلب: ج6، ص2632؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص475؛ ابن الصباغ المالكي، الفصول المهمّة: ج2، ص839.
[1416] شرح الأخبار: ج3، ص269.
[1417] إقبال الأعمال: ج3، ص101.
[1418] الآثار الباقية: ص331.
[1419] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص127؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص217؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص355؛ الصدوق، الأمالي: ص231؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص81؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص277؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص86؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص304. بينما مدّة العزاء عند عماد الدين الطبري هي سبعة أيّام، كامل البهائي: ج2، ص370. وعند المجلسي ثمانية أيّام، بحار الأنوار: ج45، ص196.
[1420] المُثلة، بفتح الميم وضم الثاء، أي العقوبة، وجمعها المَثُلات، والعرب تقول للعقوبة: مَثُلَه ومُثْلة، فمَن قال: مَثُلة جمعها على مَثُلات، ومَن قال: مُثْلة جمعها على مُثُلات ومُثَلات ومُثْلات بإِسكان الثاء، يُقال: مثلت بالحيوان أمثّل به مثلا، إذا قطعت أطرافه وشوّهت به، ومثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا من أطرافه، والاسم المثلة. فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة، ومن الثابت النهي عن المُثلة حتى بالنسبة إلى الكافر. يُنظر: ابن منظور، لسان العرب ج11، ص615. تفاصيل واسعة عن المُثلة يُنظر: الأسدي، حيدر شمخي، تاريخ المثلة في الدولة الإسلامية حتى عام 132 هـ: ص10ـ255.
[1421] مجد الدين ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج4، ص294.
[1422] الشيخ المفيد، الاختصاص: ص150؛ علي بن زيد البيهقي، معارج نهج البلاغة: ص385؛ الراوندي، منهاج البراعة: ج3، ص157؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة: ج17، ص6؛ المحب الطبري، الرياض النضرة في مناقب العشرة: ج3، ص238.
[1423] الشافعي، الأم: ج4، ص259؛ النعمان المغربي، دعائم الإسلام: ج2، ص411؛ ابن حزم، المحلّى: ج10، ص374؛ الطوسي، الخلاف: ج6، ص241؛ ابن ادريس الحلّي، السرائر: ج3، ص326.
[1424] مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي، أبو حنظلة، فارس شاعر، من أرداف الملوك في الجاهلية، يُقال له: فارس ذي الخمار وذو الخمار فرسه، وفي أمثالهم " فتى ولا كمالك "، له لمة كبيرة، أدرك الإسلام وأسلم، وولّاه رسول الله’ صدقات قومه بني يربوع، ولمّا صارت الخلافة إلى أبي بكر(11ـ13هـ/632ـ634م)، لم يدفع مالك أموال الصدقات إليه وفرّقها، فتوجّه إليه خالد بن الوليد وقبض عليه في البطاح، وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فقتله. تفاصيل أوسع عنه يُنظر: ابن حبان، الثقات: ج2، ص169؛ ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص1362؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج3، ص39؛ شريف الدين الموسوي، النصّ والاجتهاد: ص57ـ60؛ فلاح شنشل عبد الواحد، الصحابي الجليل مالك بن نويرة: ص20ـ140.
[1425] ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج4، ص295؛ المقريزي، إمتاع الأسماع: ج14، ص238؛ حسين الشاكري، الأعلام من الصحابة: ج9، ص55.
[1426] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص232؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص30؛ عبد العزيز سالم، تاريخ الدولة العربية: ص615ـ618؛ حيدر لفتة سعيد مال الله، أساليب الدولة الأموية في تثبيت السلطة: ص169ـ171.
[1427] هو محمّد بن أبي بكر، وأمّه أسماء بنت عميس الخثعمية، من السابقات إلى الإسلام، وصاحبة الهجرتين، وكنية محمّد أبو القاسم، شارك مع الإمام علي× في الجمل وصفّين. يُنظر: ابن عبد البر، الاستيعاب: ج3، ص366؛ الكندي، ولاة مصر: ج1، ص23؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج3، ص601؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة: ج4، ص144.
[1428] أبو هلال العسكري، الأوائل: ج1، ص90.
[1429] هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي، يُكّنى أبا سليمان، وأمّه أمّ الحكم بنت أبي سفيان، وخاله معاوية وذريته تسكن دمشق، وحمل جدّه عثمان لواء المشركين يوم حنين، وقتله الإمام علي بن أبي طالب×، وتولّى عبد الرحمن من قبل معاوية الكوفة ومصر، ولكنّه أساء السيرة في الكوفة فطرده أهلها، ممّا جعل والي مصر يمنعه من دخول مصر فالتحق بمعاوية، وكانت وفاته بعد معاوية. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج5، ص519؛ خليفة بن خياط، طبقات: ص561؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج35، ص43؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج3، ص287؛ ابن خلدون، تاريخ: ج3، ص16.
[1430] البلاذري، أنساب الأشراف: ج4، ص304؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص46؛ ابن حبان، الثقات: ج3، ص275؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج4، ص101؛ ابن العديم، بغية الطلب: ج8، ص3673.
[1431] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص297؛ ابن الأثير، تاريخ: ج4، ص83؛ الهيثمي، مجمع الزوائد: ج9، ص196.
[1432] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص59؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص285؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص62؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ص65.
[1433] هو مولى للإمام الحسين بن علي÷، وأرسله بكتاب إلى أخماس أهل البصرة حين كان الحسين في مكّة. يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص24؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص231؛ البخاري، التاريخ الكبير: ج4، ص13؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص265؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ج4، ص116؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص25.
[1434] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص26؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص231؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج6، ص186؛ ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص37؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص388؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص28.
[1435] يصل نسبه إلى أسد بن خزيمة، وصيدا بطن من أسد، وهو من أشراف بني صيدا، نشأ مخلصاً في محبّته لأهل البيت، وحمل كتب أهل الكوفة إلى الإمام الحسين× في المدينة، وقُبِض عليه وهو يحمل رسالة من الحسين إلى أهل الكوفة، وعندها أمر ابن زياد بقتله، وكان ذلك في أواخر سنة 60هـ/679م. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص168؛ الدينوري، الأخبار الطوال: ص246؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص306؛ الطوسي، الرجال: ص104؛ ابن شهر آشوب، مناقب: ج3، ص245؛ ابن داود، رجال: ص155؛ التفرشي، نقد الرجال: ج4، ص62؛ محمّد السماوي، إبصار العين في أنصار الحسين: ص112.
[1436] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج6، ص210؛ الشيخ المفيد، الإرشاد: ص320ـ321.
[1437] أخو الحسين بن علي من الرضاعة، أرسله الإمام الحسين× إلى الكوفة أيّام المراسلات بينه وبين أهل الكوفة، فقُبِض عليه، وقُدِّم إلى ابن زياد فأمر برميه من أعلى القصر، فتكسّرت عظامه فمات، وأمر بذبحه. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص167؛ الطوسي، رجال: ص103؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص340؛ ابن شهر آشوب، مناقب: ج3، ص232؛ الحلّي، خلاصة الأقوال: ص192؛ ابن داود، رجال: ص125.
[1438] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج6، ص211ـ212.
[1439] ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج2، ص176؛ ابن حجر العسقلاني، الاصابة: ج1، ص516.
[1440] أي قتله، ضربه صلباً، وجعله مصلوباً، والصلب هذه القتلة المعروفة، والأصل من الصليب، وهو الودك، أي تعليق الجثّة على عمود. يُنظر: الزبيدي، تاج العروس: ج2، ص149.
[1441] الشيخ المفيد، الإرشاد: ص246ـ248.
[1442] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص233؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص207؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص358.
[1443] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص201؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص183؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص314؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص55؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص431.
[1444] البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص206؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص348؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص296؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص189؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص53.
[1445] أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص203؛ الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص44؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص174؛ عبد الرزاق المقرّم، مقتل الحسين×: ص365؛ إبراهيم الزنجاني، وسيلة الدارين: ص354؛ لبيب بيضون، موسوعة كربلاء: ج2، ص263.
[1446] المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص61.
[1447] عن أعداد الرؤوس يُنظر: الفصل الأول: ص155ـ157.
[1448] إيمان أحمد جابر اللامي، خطب واقوال أهل البيت في واقعة الطف: ص142.
[1449] حسين ابوهلاله، أنصار الإمام الحسين من غير الهاشميين: ص101.
[1450] يُنظر: الفصل الثالث: ص313.
[1451] يُنظر: الفصل الثالث: ص247.
[1452] هو موضع يقع شرقي المدينة المنوّرة، وفيه قبّة العباس بن عبد المطّلب عمّ النبي. يُنظر: الهروي، الإشارات إلى معرفة الزيارات: ص80؛ السمهودي، وفاء الوفاء: ج3، ص273.
[1453] بلاد واسعة، حدودها من الغرب ما يلي العراق ازذوار، وهي قصبة جوين وبيهق، وآخر حدودها ممّا يلي الهند طخرستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها، وإنّما هو أطراف حدودها من تلك الجهات، وهي تضمّ أمّهات المدن، وفُتِحت أكثر مواضعها عنوة والآخر صلحاً سنة 31هـ/651م. يُنظر: اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص167؛ ابن الفقيه، كتاب البلدان: ص601؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص350.
[1454] بفتح أوله وسكون ثانيه وبعده واو، مدينة في بلاد فارس، وهما مدينتان مرو الروذ ومرو الشاهجان، وهي أجل كور خراسان، وفُتِحت سنة 31هـ/651م، ومرو بالفارسية هو المرج. يُنظر: اليعقوبي، البلدان: ص98؛ أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج4، ص1216؛ طارق فتحي، وفاء أحمد، مدينة مرو في المصادر الجغرافية العربية: ص24ـ35.
[1455] موضع في الكوفة، وفيه قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والغري في يومنا هذا يقع في محافظة النجف في العراق. يُنظر: أبو عبيد البكري، معجم ما أستعجم: ج3، ص996؛ ابن عبد الحقّ، مراصد الاطلاع: ج2، ص991.
[1456] هو بستان النخيل الذي يحيط به جدار. يُنظر: محمّد بن بشار بن الأنباري، الزاهر في معاني كلمات النّاس: ص460.
[1457] أنساب الأشراف: ج3، ص219.
[1458] ابن حبان، الثقات: ج3، ص69؛ مشاهير علماء الأنصار: ص25؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص477؛ السخاوي، التحفة اللطيفة: ج1، ص296. ويُنظر: أمير جواد كاظم علي بيج، الحائر الحسيني دراسة تاريخية 61ـ656هـ/680ـ1258م: ص33.
[1459] ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص85.
[1460] الثقات: ج3، ص69.
[1461] نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص477.
[1462] خزن، أصل يدلّ على صيانة الشيء، وهي مكان الخزن، أي الموضع الذي يُخزن فيه الشيء، والجمع خزائن، وتُخصّص هذه الخزائن للسلاح وغيره. الجوهري، الصحاح: ج5، ص2108؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج2، ص178.
[1463] ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص344؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص336؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص222؛ محمّد بن أحمد الدمشقي، جواهر المطالب: ج2، ص299؛ السمهودي، وفاء الوفاء: ج3، ص95.
[1464] معجم البلدان: ج2، ص469.
[1465] هو سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي، وكنيته أبو أيوب، أمّه ولادة، تُوفِّي في دابق وله من العمر خمس وأربعون سنة. يُنظر: البخاري، التاريخ الكبير: ج4، ص25؛ ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل: ج4، ص130؛ ابن منده العبدي، فتح الباب في الكُنى والألقاب: ص63؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص320.
[1466] قحل، القاف والحاء واللام أصل صحيح، يدلّ على يبس الشيء وجفافه. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج3، ص46؛ الجوهري، الصحاح: ج5، ص1799.
[1467] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص84؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص477.
[1468] يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج9، ص178ـ179؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص550؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج63، ص939؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج8، ص293.
[1469] هـو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة، وكنيته أبو العباس، وأمّه أمّ الحجاج بنت محمّد بن يوسف الثقفي، عهد إليه أبوه بالحكم بعد عمّه هشام بن عبد الملك، فتولّى الحكم في ربيع الآخر سنة 125هـ/743م، ووُصِف بسوء سيرته، وانتهاكه محارم الله تعالى، وله شعر، وعلم بالموسيقى والغناء، قُتِل في أواخر جمادى الآخرة سنة 126هـ/744 م. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج9، ص127؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص520؛ المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص212؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج7، ص5؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج63، ص319؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج5، ص289؛ أبو الفدا، المختصر في أخبار البشر: ج1، ص205.
[1470] هـو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، وكنيته أبو خالد، وأمّه فارسية، وكان أسمر نحيفاً حسن الوجه، ذوصلاح وورع، ولقب بالناقص لأنه نقّص النّاس أعطياتهم، وكانت مدّة حكمه خمسة أشهر، مات بالطاعون، ثار على ابن عمه الوليد بن يزيد لسوء سيرته، وتمّ قتله. يُنظر: خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص293؛ ابن حبيب البغدادي، المحبر: ص45؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج2، ص189؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج5، ص595؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج8، ص311؛ الكتبي، فوات الوفيات: ج2، ص646.
[1471] منصور بن جمهور، ويرجع نسبه إلى بني كلب، من أهل قرية المزة، خرج إلى جانب يزيد بن الوليد ضدّ الوليد بن يزيد، وسعى في قتله، ثمّ ولّاه يزيد العراق بجمع الكوفة والبصرة له، وكان يتبنّى فكر القدرية، ثمّ صار خارجياً بعد عزله من ولايته، وتُوفّي سنة 133هـ/750م. يُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج9، ص193؛ وكيع، أخبار القضاة: ج2، ص43؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج60، ص311.
[1472] وهي سلّة مستديرة مغشاة أدمة، تكون مع العطارين. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج6، ص185؛ الجوهري، الصحاح: ج5، ص2096.
[1473] ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص85؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص477.
[1474] البداية والنهاية: ج8، ص222.
[1475] هو عبد الله بن أبي سعد عمرو بن عبد الرحمن بن بشر بن هلال الأنصاري، وكنيته أبو محمّد، الوراق البلخي الاخباري، بلخي الأصل، سكن بغداد، وكان ثقّة، صاحب أدب وملح وطرف، ولد سنة 197هـ/812م، وقيل سنة 199هـ/814م، وتُوفّي في واسط، ودُفِن في جانبها الشرقي، وعمره سبع وسبعون سنة. يُنظر: الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد: ج10، ص27؛ السمعاني، الأنساب: ج1، ص94ـ95؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج12، ص263.
[1476] أبو معيط بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي واسم أبي معيط أبان، وأمّه أميّة بنت أبان بن كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج63، ص221؛ ابن الأثير، أُسْدُ الغابة: ج5، ص614.
[1477] هو نبات يخضب بورقه، ويُقال هو العظلم، والوسمة ورق النيل أو نبات يختضب بورقه. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج4، ص62؛ فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج6، ص184.
[1478] تذكرة الخواص: ص337.
[1479] ابن العمراني، الأنباء في تاريخ الخلفاء: ص54.
[1480] الإشارات إلى معرفة الزيارات: ص36.
[1481] تذكرة الخواص: ص337.
[1482] نور الابصار: ص269.
[1483] صبح الاعشى بصناعة الإنشاء: ج3، ص412.
[1484] اتّعاظ الحنفاء بأخبار الأئمّة الفاطميّين الخلفاء: ج3، ص22.
[1485] الطبقات الكبرى: ص27.
[1486] نور الابصار: ص269ـ270.
[1487] تذكرة الخواص: ص337.
[1488] مثير الأحزان: ص85.
[1489] رحلة ابن جبير: ص18ـ19.
[1490] المصدر السابق: ص252.
[1491] هي الحروب التي شنّها الفرنجة، على بلاد الشام، واستمرّت قرنينِ من الزمان (488ـ690هـ/ 1095ـ1291م)، وقد اتّخذت من الصليب الأحمر شعاراً لها، وأطلق المؤرِّخون المسلمون على هؤلاء الصليبيين اسم الفرنجة، وأعدّ الصليبي عندهم نوعا من الحاجّ عالي المكانة، الذي نال شرف حمل السلاح، وبهذا حصلت عملية التحويل من حاجّ مسلح إلى جندي للعقيدة في الجيش الصليبي نفسه. تفاصيل أوسع عن الحملات الصليبية. يُنظر: انثوني وليست، الحروب الصليبية: ص77ـ93؛ علي سعود، تاريخ الحروب الصليبية: ص10ـ336؛ سعيد عبد الفتّاح، الحركات الصليبية: ج2، ص595ـ635؛ سمير صالح، عباس عاجل، الحروب الصليبية تطوّر المصطلح والمفهوم: ص109ـ133.
[1492] علي الحريري، الأخبار السنية في الحروب الصليبية: ص104ـ105؛ وليم، تاريخ الحروب الصليبية: ج2، ص809ـ820؛ انتهاء خالد حميد، أثر الخلافة الفاطمية في الحروب الصليبية: ص159ـ162.
[1493] ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص142؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص222؛ المقريزي، المواعظ والاعتبار: ج1، ص289؛ الحميري، الروض المعطار: ص239.
[1494] هو عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد أبي أحيحة بن العاص بن أميّة بن عبد شمس، وأمّه أمّ البنين بنت الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عَبْد شمس، المعروف بالأشدق، ولّاه معاوية ويزيد المدينة. يُنظر: ابن سعد، الطبقات: ج5، ص183؛ أحمد بن علي بن محمّد بن إبراهيم، رجال صحيح مسلم: ج2، ص69؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج46، ص29؛ أبو الفضل، مختصر تاريخ دمشق: ج19، ص214.
[1495] ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص238؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص217؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص344؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص75؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج5، ص20؛ اليافعي، مرآة الجنان: ج1، ص110؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص213؛ السمهودي، وفاء الوفاء: ج3، ص95.
[1496] النعمان المغربي، شرح الأخبار: ج3، ص161؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص336.
[1497] تذكرة الخواص: ص336.
[1498] رأس الحسين: ص197.
[1499] نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص476.
[1500] السمهودي، خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى: ج2، ص376.
[1501] هو الإمام محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي المدني، كنيته أبو جعفر، ولقبه الباقر، كانت ولادته في سنة 56هـ/675م، أو 57هـ/676م، أو 58هـ/677م، أو 59هـ/678 م، تُوفِّى في سنة 114هـ/732م، ودُفِن في البقيع. تفاصيل أوسع عن سيرته وحياته الفكرية يُنظر: محمّد عبيد حميد الطائي، الإمام الباقر ومروياته التاريخية (56ـ114هـ): ص167ـ192.
[1502] جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، وله عدّة ألقاب، منها: الصابر والفاضل والطاهر، وأشهرها الصادق، وأُمّه أمّ فروة بنت القاسم بن محمّد بن أبي بكر، وبلغت المدرسة العلمية التي أسّسها أبوه الإمام الباقر أوج ازدهارها في عهده، واستمرّت إمامته لمدّة (34) سنة، تُوفِّي سنة 148هـ/765م، وله ستّة وستّون عاما. اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص381؛ الطبرسي، تاج المواليد: ص42ـ43؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج2، ص8؛ عبد الملك بن حسين العصامي المكّي، سمط النجوم العوالي: ج4، ص135.
[1503] شمس الدين السخاوي، التحفة اللطيفة بتاريخ المدينة الشريفة: ج1، ص41.
[1504] الرباط، وجمعه ربط، وهو المكان الذي يُلازم فيه المقاتلون ثغر العدو. الفراهيدي، العين: ج7، ص423؛ الجوهري، الصحاح: ج3، ص1127.
[1505] الفرسخ يساوي ثلاثة أميال، أي: 6 كم. ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج1، ص36؛ هنتس، المكاييل والاوزان: ص94.
[1506] المقدسي، أحسن التقاسيم: ص333.
[1507] المجوس، نسبة إلى المجوسية، وهي إحدى الديانات الفارسية القديمة، كان لهم نبي فقتلوه، وجاءهم بكتاب فاحرقوه، ثمّ اخذوا يعتقدون بأنّ الله تعالى هو النور الأعلى وهو يزدان، وأنّ الشيطان من جنس الظلمة وهو اهرمن. الكليني، الكافي: ج3 ص568؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: ج4 ص113؛ الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى: ج2 ص284؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام: ج12، ص65؛ الفاضل الهندي، كشف اللثام: ج7، ص87.
[1508] الأنساب: ج3، ص370ـ371.
[1509] ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص222.
[1510] هو عبد الرحمن بن مسلم، القائم بالدعوة العباسية، قيل: كان قصيراً أسمر فصيحاً حلو المنطق، عالماً بالأمور، ومن أدباء اصبهان، وُلِد بكرخ اصبهان، قتله أبو جعفر المنصور العباسي في شعبان سنة 137هـ/754م. يُنظر: أبو الشيخ الأصبهاني، طبقات المحدّثين بأصبهان: ج1، ص133؛ ابن حبان، الثقات: ج2، ص445؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج35، ص408؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج6، ص48؛ عباس القمّي، الكُنى والألقاب: ج1، ص157.
[1511] سبط بن الجوزي، مرآة الزمان في تواريخ الاعيان، حوادث سنة 50، مخطوطة.
[1512] لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1513] منصور بن طلحة بن طاهر بن الحسين، هو الأمير أبو العباس الطاهري، من أحفاد طاهر بن الحسين، مؤسّس الامارة الطاهرية(205ـ259هـ/820ـ872م)، ولي أمرة مرو، آمل، ذمر وخوارزم، وكان عالماً شاعراً أديباً بارعاً، مدح بعض الخلفاء العباسيين، ويُعدّ حكيم الأسرة الطاهرية، وله مؤلّفات في الفلسفة، منها كتاب المؤنس في الموسيقى، وكتاب الابانة عن أفعال الفلك، وكتاب الوجود، ورسالته في العدد والمعدود، وغيرها، تُوفِّي سنة 250هـ/864م، وقيل: سنة 258هـ/871م. يُنظر: ابن النديم، الفهرست: ص130؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج6، ص216؛ اسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين: ج2، ص472؛ عمر كحالة، معجم المؤلِّفين: ج13، ص15.
[1514] وهدة، الأرض المنخفضة، أي الهوة في الأرض، أي الحفرة. الفيروزآبادي، القاموس المحيط: ج1، ص347؛ الزبيدي، تاج العروس: ج5، ص329.
[1515] الطاق، وهو ما عطف من الأبنية، أي عقد البناء ذو السقف المقوّس، والجمع، الطاقات، الطيقان، الأطواق. الجوهري، الصحاح: ج4، ص1519؛ ابن منظور، لسان العرب: ج10، ص233.
[1516] سبط بن الجوزي، مرآة الزمان، مخطوطة، حوادث سنة 50ـ89هـ، ورقة 102.
[1517] لم نعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا.
[1518] الثوية، بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد الياء أخت الواو، موضع وراء الحيرة، قريب من الكوفة، وكانت سجناً للنعمان بن المنذر، كان يحبس بها من أراد قتله، فكان يُقال لِمَن حُبِس بها: ثوى، أي: أقام، فسُمِّيت الثوية. يُنظر: أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم: ج1، ص350؛ الزمخشري، الجبال والأمكنة والمياه: ص80؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج2، ص87.
[1519] الذكوات: جمع ذكاة، وهي الجمرة الملتهبة من الحصى. يُنظر: فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين: ج1، ص159.
[1520] إبراهيم بن محمّد الثقفي، الغارات: ج2، ص852؛ الكليني، الكافي: ج4، ص571؛ الفيض الكاشاني، الوافي: ج14، ص1413.
[1521] يونس بن ظبيان مولى، يُعدّ من الضعفاء، لا يُلتفت إلى ما رواه، كلّ كتبه تخليط. يُنظر: رجال النجاشي : ص448؛ محمّد الجواهري، المفيد من رجال الحديث: ص778.
[1522] أكم، الهمزة والكاف والميم أصل واحد، وهي تجمّع الشيء وارتفاعه قليلاً، والأكم: تلّ من قفّ، وجمعه: الأُكم والأَكم والآكام. يُنظر: الفراهيدي، العين: ج5، ص420؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج1، ص125.
[1523] ابن قولويه، كامل الزيارات: ص86؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج97، ص243.
[1524] الجواهري، جواهر الكلام: ج20، ص93.
[1525] الصدوق، الأمالي: ص233؛ البيروني، الآثار الباقية: ص331؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص114؛ القزويني، عجائب المخلوقات: ص45؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص477؛ الشبراوي، الإتحاف بحبّ الأشراف: ص127.
[1526] ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص85.
[1527] ابن الجوزي، تذكرة الخواص: ص336.
[1528] عن عمر بن عبد العزيز يُنظر: أحمد عبيد عيسى، الجانب الاجتماعي لخلافة عمر بن عبد العزيز من خلال كتاب ابن الجوزي : ص66ـ78.
[1529] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص84؛ النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص477.
[1530] حياة الإمام الحسين بن علي÷: ج3، ص431.
[1531] الإتحاف بحبّ الأشراف: ص127.
[1532] المنتظم: ج5، ص344.
[1533] الآثار الباقية: ص331.
[1534] عجائب المخلوقات: ص45.
[1535] الصدوق، الأمالي: ص231.
[1536] طاهر آل عكلة، رأس الحسين: ص196.
[1537] الحسن بن يسار البصري أبو سعيد، تابعي، إمام أهل البصرة، وهو من العلماء الفقهاء الفصحاء النسّاك، وُلِد في المدينة سنة 21هـ/642م، وشبّ في كنف الإمام علي بن أبي طالب×، سكن البصرة، وكانت أمّه تخدم أمّ سلمة زوج النبي، تُوفي سنة 110هـ/728م. يُنظر: البخاري، التاريخ الصغير: ج1، ص2980؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج12، ص190؛ عمر حميد مراد، عصام خليل إبراهيم، مواقف العلماء من رواية الحسن البصري عن الإمام علي: ص182.
[1538] ابن شهر آشوب، مناقب: ج3، ص220؛ محمّد بن يوسف الزرندي، نظم درر السمطين: ص226؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص626. والجائزة السنية: العطاء. يُنظر: الجوهري، الصحاح: ج3، ص871؛ ابن منظور، لسان العرب: ج5، ص328.
[1539] رأس الحسين: ص190ـ195. والحواريون، هم أصحاب النبي عيسى بن مريم، وسُمّوا بذلك؛ لأنّهم كانوا يقصرون الثياب والوسخ بالغسل، وأنّهم مخلصون في أنفسهم ولغيرهم من أوساخ الذنوب. يُنظر: ابن سلام، غريب الحديث: ج2، ص15؛ ابن منظور، لسان العرب: ج4، ص220.
[1540] نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص481.
[1541] ابن تيمية، رأس الحسين: ص215.
[1542] ابن كثير، البداية والنهاية: ج 8، ص222.
[1543] عن النسب الفاطمي، يُنظر: مرتضى حسن النقيب، دراسات في التأريخ والآثار: ص1ـ16.
[1544] المستنصر بالله اسمه معد، وكنيته أبو تميم، ولقبه المستنصر بالله بن الظاهر لاعزاز دين الله بن الحاكم، بن العزيز، بن المعزّ لدين الله. ولي الحكم بعد أبيه وله من العمر سبع سنين سنة 427هـ/1035م، وامتدّت أيّامه حوالي ستّين سنة. تفاصيل أوسع عن سيرة وأحداث عصر المستنصر بالله الفاطمي يُنظر: يلدز داود سلمان، المستنصر بالله الفاطمي دراسة في سياسته الداخلية والخارجية 427ـ487هـ/1035ـ1094م: ص2ـ23.
[1545] أحمد صبري، رأس الحسين تناقض العوامل ومنهج الحراك التاريخي: ص34ـ35. وعن الحكم الفاطمي في العراق يُنظر: المقريزي، المواعظ والاعتبار: ج1، ص356.
[1546] ابن تيمية، رأس الحسين: ص215؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص222.
[1547] صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج3، ص412.
[1548] اتّعاظ الحنفاء بأخبار الأئمّة الفاطميّين الخلفاء: ج3، ص22.
[1549] ثورة الإمام الحسين في المصنّفات المصرية في القرن العشرين الميلادي: ص330ـ331.
[1550] يُنظر في ذلك كلّ من: أحمد صبري، رأس الحسين، تناقض العوامل ومنهج الحراك التاريخي؛ أحمد أبو كف، آل بيت النبي في مصر: ص37ـ38؛ جاسم عثمان مرغي، الشيعة في مصر: ص147ـ156.
[1551] البخاري، صحيح: ج5، ص82؛ البلاذري، أنساب الأشراف: ج1، ص405؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص115؛ أحمد بن حسين البيهقي، السنن الكبرى: ج4، ص31؛ الفتّال النيسابوري، روضة الواعظين: ص152؛ العيني، عمدة القارئ: ج17، ص258.
[1552] المقريزي، إمتاع الأسماع: ج5، ص353.
[1553] ابن جبير، الرحلة: ص155.
[1554] هو عبد اللَّه بن علي بن عبد اللَّه بن العباس بن عبد المطّلب الهاشمي، عمّ أبي جعفر المنصور (95ـ147هـ/713ـ764 م)، ولّاه أبو العباس السفّاح ـ أول الحكّام العباسيين ـ حرب مروان ابن محمّد آخر الحكّام الأمويين، فسار إليه حتى قتله واستولى على بلاد الشام، ولم يزل عليها مدّة خلافة السفاح(132ـ136هـ/750ـ755م)، فلمّا ولي أبو جعفر المنصور العباسي اختلف معه ودعا إلى نفسه، فوجّه إليه المنصور أبا مسلم فحاربه بنصيبين، فانهزم عبد اللَّه بن عَليّ واختفى، وصار إلى البصرة فأشخصه سليمان بن علي والي البصرة إلى بغداد، فحبسه أبو جعفر المنصور، ولم يزل في حبسه ببغداد حتى وقع عليه البيت الذي حُبِس فيه فقتله. عن سيرة عبد الله بن علي ودوره السياسي والعسكري يُنظر: سفانه رعد خليل إبراهيم الحيالي، عبد الله بن علي 95ـ147هـ/713ـ764م سيرته ودوره السياسي والعسكري: ص80ـ144.
[1555] يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج6، ص88ـ91.
[1556] النويري، نهاية الأرب في فنون الأدب: ج20، ص481.
[1557] أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث: ج21، ص126؛ محمّد الجواهري، المفيد من معجم رجال الحديث: ص671؛ غلام رضا عرفانيان، مشايخ الثقات: ص147.
[1558] مثير الأحزان: ص76.
[1559] إبراهيم بن محمّد الثقفي، الغارات: ج2، ص862ـ863؛ عبد الكريم بن طاووس، فرحة الغري: ص17؛ الحسن بن محمّد، ارشاد القلوب: ج2، ص436؛ ابن عنبة، عمدة الطالب: ص62؛ محسن الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص536.
[1560] النجاشي، رجال: ص448.
[1561] ثامن أئمّة أهل البيت، علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن، ولقبه الرضا من سادات أهل البيت، مات في طوس من شربة دُسّ فيها السمّ، سقاه إيّاها المأمون، فمات من ساعته في يوم السبت آخر يوم سنة 203هـ/818م. يُنظر: الخصيبي، الهداية الكبرى: ص279؛ ابن رستم الطبري، دلائل الإمامة: ص358ـ359؛ ابن حبان، الثقات: ج8، ص457؛ ابن شهر آشوب، مناقب: ج3، ص475؛ إيمان سالم، علي بن موسى الرضا وولاية العهد: ص217ـ241؛ حسين عبد العال اللهيبي، دور الإمام علي بن موسى الرضا في الحراك الفكري والسياسي: ص35ـ46.
[1562] الطوسي، رجال الكشي: ج2، ص659؛ النوري الطبرسي، خاتمة المستدرك: ج9، ص233؛ أبو القاسم الخوئي، معجم رجال الحديث: ج21، ص204ـ205.
[1563] السيد الخوئي، معجم رجال الحديث: ج21، ص205.
[1564] عباس الربيعي، أطلس الحسين: ص355؛ هادي عبد النبي التميمي، ثورة الإمام الحسين في المصنّفات المصرية: ص323.
[1565] مشهد الإمام علي في النجف وما به من الهدايا والتّحف: ص153.
[1566] الكليني، الكافي: ج4، ص571.
[1567] بن قولويه، كامل الزيارات: ص84.
[1568] الطوسي، تهذيب الأحكام: ج6، ص35؛ الطوسي، الأمالي: ص682.
[1569] المشهدي، المزار: ص517.
[1570] المصدر السابق: ص33، 67.
[1571] سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص329.
[1572] ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص121ـ122؛ الطبرسي، الاحتجاج: ج2، ص196؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ص261؛ ؛ ابن نما الحلّي، مثير الأحزان: ص66؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص86.
[1573]الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص45ـ47
[1574] الروم: آية10.
[1575] آل عمران: آية178.
[1576] آل عمران: آية169.
[1577] الكهف: آية50.
[1578] مريم: آية75.
[1579] الحج: آية10.
[1580] هود: آية18.
[1581] آل عمران: آية173.
[1582] الأنفال: آية40.
[1583] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص71ـ74.
[1584] الخوارزمي، مقتل الحسين×: ج2، ص76ـ78.
[1585]للاطلاع على الخارطة اضغط على الرابط التالي : https://admin.warithanbia.com/files/images/1015848459_1698125775.png
[1586]للاطلاع على الخارطة اضغط على الرابط التالي : https://admin.warithanbia.com/files/images/547542851_1698125845.png
[1587]للاطلاع على الخارطة اضغط على الرابط التالي : https://admin.warithanbia.com/files/images/1299949723_1698125914.png
[1588]للاطلاع على الخارطة اضغط على الرابط التالي : https://admin.warithanbia.com/files/images/709047280_1698125985.png
[1589]للاطلاع على المخطط اضغط على الرابط التالي : https://admin.warithanbia.com/files/images/1064233523_1698126101.jpg
[1590] للاطلاع على المخطط اضغط على الرابط التالي : https://admin.warithanbia.com/files/images/1171174749_1698126182.jpg
[1591]للاطلاع على الخارطة اضغط على الرابط التالي : https://admin.warithanbia.com/files/images/1376197910_1698126291.png
[1592] للاطلاع على الخارطة اضغط على الرابط التالي : https://admin.warithanbia.com/files/images/625303024_1698126383.jpg