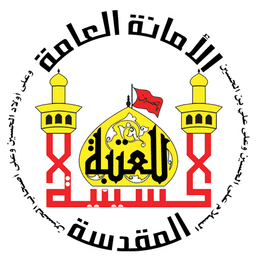بسم الله الرحمن الرحيم
(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)
(الأحزاب: 33) صدق الله العلي العظيم
إلى مَن حُقَّ لي أن أفتخر بانتمائي إليه..
مصدر ثقتي واعتزازي..
إلى مَن عانى سنين لأجل تلك اللحظات المثمرة..
إلى القلب الطيب..
إلى معلمي الأول وقدوتي في الحياة..
إلى السيد الوالد..
إنساناً وأباً وداعية..
إلى ينبوع المحبة والحنان..
أُمِّي العزيزة.. وفاءً وإخلاصاً
إلى مَن أشدُّ بهم أزري وسندي في الحياة.. أخوايَ
لؤي وياسر.. حبّاً وعرفاناً
اللهمَّ اجزهم خيرَ الجزاء
شكر وتقدير
لا يسعني وأنا أكمل جهدي المتواضع هذا، إلاّ أن أتقدَّم بفائق شكري وجزيل امتناني إلى أستاذي المشرف الأستاذ المساعد الدكتور نعمة شهاب جمعة يوسف على صبره وسعة صدره، وتحمُّله مراجعاتي المتكرِّرة له، فكان له الأثر الكبير في إكمال الرسالة.
كما أتقدَّم بشكري وعرفاني إلى الدكتور ثامر لفتة الساعدي، الذي رافقني طوال مدَّة دراستي في الماجستير، وأتقدَّم بالشكر إلى الأستاذ المساعد الدكتور محمود تركي اللهيبي؛ الذي كان السبب في اختيار الموضوع، وأتقدَّم بشكري وعرفاني إلى الأستاذ المساعد الدكتور داود سلمان الزبيدي والذي لولاه لم يُقرَّ الموضوع؛ فجعل الله هذا في ميزان حسناته، وأتقدَّم بشكري إلى الأستاذ المساعد الدكتور حسين داخل البهادلي، والدكتور نذير صبار؛ اللذين قدّما لي جهوداً متميّزة في إخراج هذا الجهد بصورته النهائية، كما أتقدَّم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي في السنة التحضيرية؛ الذين كانت لتوجيهاتهم العلمية الأثر الكبير في كتابة الرسالة.
ولا يسعني في هذا المجال إلاّ أن أتقدَّم بوافر تقديري وشكري إلى أسرتي التي رافقتني على مدار دراستي في الجامعة، فأقدِّم شكري إلى والدي ووالدتي؛ حيث كانا الشمعة التي أنارت لي طريق العلم... وإخوتي (لؤي وياسر) اللذين أسديا لي كلَّ ما أحتاجه في إعداد الرسالة.
وأتقدَّم بالشكر الجزيل إلى زميلي حيدر سالم المالكي؛ على ما قدَّمه لي من مشورة وإرشاد إلى المصادر التي ساهمت في إتمام هذا الجهد.
وأخيراً أتقدَّم بالشكر إلى العاملين في المكتبة الحيدرية في النجف الأشرف، والمكتبة الكاظمية المقدّسة.
الباحثة
الرموز والمصطلحات التي استخدمتها داخل الرسالة
|
الرمز |
المصطلح |
|
ت |
تُوفِّي |
|
تح |
تحقيق |
|
ج |
جزء |
|
د. ت |
دون تاريخ |
|
د. م |
دون مكان |
|
ش |
الشهر الشمسي |
|
ص |
صفحة |
|
ط |
طبعة |
|
ق هـ |
قبل الهجرة |
|
هـ |
هجري |
مقدِّمة المؤسّسة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
إنّ العلم والمعرفة مصدر الإشعاع الذي يهدي الإنسان إلى الطريق القويم، ومن خلالهما يمكنه أن يصل إلى غايته الحقيقية وسعادته الأبدية المنشودة، فبهما يتميّز الحقّ من الباطل، وبهما تُحدد اختيارات الإنسان الصحيحة، وعلى ضوئهما يسير في سبل الهداية وطريق الرشاد الذي خُلق من أجله، بل على أساس العلم والمعرفة فضّله الله عز وجل على سائر المخلوقات، واحتج عليهم بقوله: (وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)([1]) ، فبالعلم يرتقي المرء وبالجهل يتسافل، وقد جاء في الأثر «العلمُ نورٌ»([2])، كما بالعلم والمعرفة تتفاوت مقامات البشر ويتفوّق بعضهم على بعض عند الله عز وجل، إذ (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)([3])، وبهما تسعد المجتمعات، وبهما الإعمار والازدهار، وبهما الخير كلّ الخير.
ومن أجل العلم والمعرفة كانت التضحيات الكبيرة التي قدّمها الأنبياء والأئمة والأولياء^، تضحيات جسام كان هدفها منع الجهل والظلام والانحراف، تضحيات كانت غايتها إيصال المجتمع الإنساني إلى مبتغاه وهدفه، إلى كماله، إلى حيث يجب أن يصل ويكون، فكان العلم والمعرفة هدف الأنبياء المنشود لمجتمعاتهم، وتوسّلوا إلى الله عز وجل بغية إرسال الرسل التي تعلّم المجتمعات فقالوا: (وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)([4])، و(لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) ([5])، ما يعني أنّ دون العلم والمعرفة هو الضلال المبين والخسران العظيم.
بل هو دعاؤهم^ ومبتغاهم من الله عز وجل لأنفسهم أيضاً، إذ طلبوا منه تعالى بقولهم: «وَاملأ قُلُوبَنا بِالْعِلْمِ وَالمَعْرفَةِ»([6]).
وبالعلم والمعرفة لا بدّ أن تُثمّن تلك التضحيات، وتُقدّس تلك الشخصيات التي ضحّت بكلّ شيء من أجل الحقّ والحقيقة، من أجل أن نكون على علم وبصيرة، من أجل أن يصل إلينا النور الإلهي، من أجل أن لا يسود الجهل والظلام.
فهذه هي سيرة الأنبياء والأئمة^ سيرة الجهاد والنضال والتضحية والإيثار لأجل نشـر العلم والمعرفة في مجتمعاتهم، تلك السيرة الحافلة بالعلم والمعرفة في كلّ جانب من جوانبها، والتي ينهل منها علماؤنا في التصدّي لحلّ مشاكل مجتمعاتهم على مرّ العصور والأزمنة والأمكنة، وفي كافّة المجالات وشؤون البشر.
وهذه القاعدة التي أسسنا لها لا يُستثنى منها أيّ نبي أو وصي، فلكلّ منهم^ سيرته العطرة التي ينهل منها البشر للهداية والصلاح، إلّا أنّه يتفاوت الأمر بين أفرادهم من حيث الشدّة والضعف، وهو أمر عائد إلى المهام التي أنيطت بهم^، كما أخبر عز وجل بذلك في قوله: (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ)([7])، فسيرة النبي الأكرم’ ليست كبقية سير الأنبياء، كما أنّ سيرة الأئمة^ ليست كبقية سير الأوصياء السابقين، كما أنّ التفاوت في سير الأئمة^ فيما بينهم مما لا شك فيه، كما في تفضيل أصحاب الكساء على بقية الأئمة^.
والإمام الحسين× تلك الشخصية القمّة في العلم والمعرفة والجهاد والتضحية والإيثار، أحد أصحاب الكساء الخمسة التي دلّت النصوص على فضلهم ومنزلتهم على سائر المخلوقات، الإمام الحسين× الذي قدّم كلّ شيء من أجل بقاء النور الرباني، الذي يأبى الله أن ينطفئ، الإمام الحسين× الذي بتضحيته تعلّمنا وعرفنا، فبقينا.
فمن سيرة هذه الشخصية العظيمة التي ملأت أركان الوجود تعلَّم الإنسان القيم المثلى التي بها حياته الكريمة، كالإباء والتحمّل والصبر في سبيل الوقوف بوجه الظلم، وغيرها من القيم المعرفية والعملية، التي كرَّس علماؤنا الأعلام جهودهم وأفنوا أعمارهم من أجل إيصالها إلى مجتمعات كانت ولا زالت بأمس الحاجة إلى هذه القيم، وتلك الجهود التي بُذلت من قبل الأعلام جديرة بالثناء والتقدير؛ إذ بذلوا ما بوسعهم وأفنوا أغلى أوقاتهم وزهرة أعمارهم لأجل هذا الهدف النبيل.
إلّا أنّ هذا لا يعني سدّ أبواب البحث والتنقيب في الكنوز المعرفية التي تركها× للأجيال اللاحقة ـ فضلاً عن الجوانب المعرفية في حياة سائر المعصومين^ ـ إذ بقي منها من الجوانب ما لم يُسلّط الضوء عليه بالمقدار المطلوب، وهي ليست بالقليل، بل لا نجانب الحقيقة فيما لو قلنا: بل هي أكثر مما تناولته أقلام علمائنا بكثير، فلا بدّ لها أن تُعرَف لتُعرَّف، بل لا بدّ من العمل على البحث فيها ودراستها من زوايا متعددة، لتكون منهجاً للحياة، وهذا ما يزيد من مسؤولية المهتمين بالشأن الديني، ويحتّم عليهم تحمّل أعباء التصدّي لهذه المهمّة الجسيمة؛ استكمالاً للجهود المباركة التي قدّمها علماء الدين ومراجع الطائفة الحقّة.
ومن هذا المنطلق؛ بادرت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدّسة لتخصيص سهم وافر من جهودها ومشاريعها الفكرية والعلمية حول شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة؛ إذ إنّها المعنيّة بالدرجة الأولى والأساس بمسك هذا الملف التخصصي، فعمدت إلى زرع بذرة ضمن أروقتها القدسية، فكانت نتيجة هذه البذرة المباركة إنشاء مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، التابعة للعتبة الحسينية المقدّسة، حيث أخذت على عاتقها مهمّة تسليط الضوء ـ بالبحث والتحقيق العلميين ـ على شخصية الإمام الحسين× ونهضته المباركة وسيرته العطرة، وكلماته الهادية، وفق خطة مبرمجة وآلية متقنة، تمّت دراستها وعرضها على المختصين في هذا الشأن؛ ليتمّ اعتمادها والعمل عليها ضمن مجموعة من المشاريع العلمية التخصصية، فكان كلّ مشروع من تلك المشاريع متكفّلاً بجانب من الجوانب المهمّة في النهضة الحسينية المقدّسة.
كما ليس لنا أن ندّعي ـ ولم يدّعِ غيرنا من قبل ـ الإلمام والإحاطة بتمام جوانب شخصية الإمام العظيم ونهضته المباركة، إلّا أنّنا قد أخذنا على أنفسنا بذل قصارى جهدنا، وتقديم ما بوسعنا من إمكانات في سبيل خدمة سيّد الشهداء×، وإيصال أهدافه السامية إلى الأجيال اللاحقة.
المشاريع العلمية في المؤسسة
بعد الدراسة المتواصلة التي قامت بها مؤسَّسة وارث الأنبياء حول المشاريع العلمية في المجال الحسيني، تمّ الوقوف على مجموعة كبيرة من المشاريع التي لم يُسلَّط الضوء عليها كما يُراد لها، وهي مشاريع كثيرة وكبيرة في نفس الوقت، ولكلٍّ منها أهميته القصوى، ووفقاً لجدول الأولويات المعتمد في المؤسَّسة تمّ اختيار المشاريع العلميّة الأكثر أهميّة، والتي يُعتبر العمل عليها إسهاماً في تحقيق نقلة نوعية للتراث والفكر الحسيني، وهذه المشاريع هي:
الأوّل: قسم التأليف والتحقيق
إنّ العمل في هذا القسم على مستويين:
أ ـ التأليف
ويُعنَى هذا القسم بالكتابة في العناوين الحسينية التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما يتمُّ استقبال النتاجات القيِّمة التي أُلِّفت من قبل العلماء والباحثين في هذا القسم؛ ليتمَّ إخضاعها للتحكيم العلمي، وبعد إبداء الملاحظات العلمية وإجراء التعديلات اللازمة بالتوافق مع مؤلِّفيها يتمّ طباعتها ونشرها.
ب ـ التحقيق
والعمل فيه قائم على جمع وتحقيق وتنظيم التراث المكتوب عن مقتل الإمام الحسين×، ويشمل جميع الكتب في هذا المجال، سواء التي كانت بكتابٍ مستقلٍّ أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (موسوعة المقاتل الحسينيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على رصد المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ ليتمَّ جمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتمُّ استقبال الكتب التي تمّ تحقيقها خارج المؤسَّسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد إخضاعها للتقييم العلمي من قبل اللجنة العلمية في المؤسَّسة، وبعد إدخال التعديلات اللازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر تقوم المؤسَّسة بطباعتها.
الثاني: مجلّة الإصلاح الحسيني
وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسلِّط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية والفقهية والأدبية في تلك النهضة المباركة، وقد قطعت شوطاً كبيراً في مجالها، واحتلّت الصدارة بين المجلات العلمية الرصينة في مجالها، وأسهمت في إثراء واقعنا الفكري بالبحوث العلمية الرصينة.
الثالث: قسم ردّ الشُّبُهات عن النهضة الحسينية
إنّ العمل في هذا القسم قائم على جمع الشُّبُهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، وذلك من خلال تتبع مظانّ تلك الشُّبُهات من كتب قديمة أو حديثة، ومقالات وبحوث وندوات وبرامج تلفزيونية وما إلى ذلك، ثُمَّ يتمُّ فرزها وتبويبها وعنونتها ضمن جدول موضوعي، ثمّ يتمُّ الردُّ عليها بأُسلوب علميّ تحقيقي في عدَّة مستويات.
الرابع: الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×
وهي موسوعة علمية تخصصية مستخرَجة من كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ويكون ذلك من خلال جمع كلمات الإمام الحسين× من المصادر المعتبرة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية مع بيان لتلك الكلمات، ثمّ وضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام× والواقع العلمي.
الخامس: قسم دائرة معارف الإمام الحسين× أو (الموسوعة الألفبائية الحسينية)
وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالإمام الحسين× ونهضته المباركة من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأعلام وبلدان وأماكن، وكتب، وغير ذلك، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعَى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، مكتوبة بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ حديث.
السادس: قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
إنّ العمل في هذا القسم يتمحور حول أمرين: الأوّل: إحصاء الرسائل والأطاريح الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، الثاني: إعداد موضوعات حسينيّة من قبل اللجنة العلمية في هذا القسم، تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية، تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.
السابع: قسم الترجمة
يقوم هذا القسم بمتابعة التراث المكتوب حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة باللغات غير العربية لنقله إلى العربية، ويكون ذلك من خلال تأييد صلاحيته للترجمة، ثمَّ ترجمته أو الإشراف على ترجمته إذا كانت الترجمة خارج القسم.
الثامن: قسم الرَّصَد والإحصاء
يتمُّ في هذا القسم رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في جميع الوسائل المتّبعة في نشر العلم والثقافة، كالفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية في شتّى المجالات.
التاسع: قسم المؤتمرات والندوات العلمية
ويتمّ العمل في هذا القسم على إقامة مؤتمرات وملتقيات وندوات علميّة فكرية متخصّصة في النهضة الحسينية، لغرض الإفادة من الأقلام الرائدة والإمكانات الواعدة، ليتمّ طرحها في جوٍّ علميّ بمحضر الأساتذة والباحثين والمحقّقين من ذوي الاختصاص، كما تتمّ دعوة العلماء والمفكِّرين؛ لطرح أفكارهم ورؤاهم القيِّمة على الكوادر العلمية في المؤسَّسة، وكذا سائر الباحثين والمحققين وكلّ من لديه اهتمام بالشأن الحسيني، للاستفادة من طرق قراءتهم للنصوص الحسينية وفق الأدوات الاستنباطية المعتمَدة لديهم.
العاشر: قسم المكتبة الحسينية التخصصية
وهي مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المخطوط والمطبوع، أنشأتها مؤسَّسة وارث الأنبياء، وهي تجمع آلاف الكتب المهمّة في مجال تخصُّصها.
الحادي عشر: قسم الموقع الإلكتروني
وهو موقع إلكتروني متخصِّص بنشر نتاجات وفعاليات مؤسَّسة وارث الأنبياء، يقوم بنـشر وعرض كتبها ومجلاتها التي تصدرها، وكذا الندوات والمؤتمرات التي تقيمها، وكذا يسلِّط الضوء على أخبار المؤسَّسة، ومجمل فعالياتها العلمية والإعلامية.
الثاني عشر: القسم النسوي
يعمل هذا القسم من خلال كادر علمي متخصص وبأقلام علمية نسوية في الجانب الديني والأكاديمي على تفعيل دور المرأة المسلمة في الفكر الحسيني، كما يقوم بتأهيل الباحثات والكاتبات ضمن ورشات عمل تدريبية، وفق الأساليب المعاصرة في التأليف والكتابة.
الثالث عشر: القسم الفني
إنّ العمل في هذا القسم قائم على طباعة وإخراج النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسَّسة، من خلال برامج إلكترونية متطوِّرة يُشرف عليها كادر فنيّ متخصِّص، يعمل على تصميم الأغلفة وواجهات الصفحات الإلكترونية، وبرمجة الإعلانات المرئية والمسموعة وغيرهما، وسائر الأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها كافّة الأقسام.
وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها إن شاء الله تعالى.
هذه الرسالة : السيّدة سكينة بنت الحسين÷ ـ دراسة تأريخية
إنّ الأهميّة التي يضطلع بها كلّ فرد تعود عادة إلى المواقف والمسارات التي ينتخبها في حياته والاختيارات التي يعمل عليها حيث إنّها تشكّل هويته ورؤيته حول الواقع وما يتطلّبه الموقف الصحيح، وكلّما كانت تلك الخيارات في طريق الحقيقة كانت تلك الشخصية محلاً للاحترام والتقدير، وكلّما ازدادت تلك المواقف صعوبة وخطورة كلّما ازداد الاهتمام بتلك الشخصية. كما لا يخفى الدور الكبير لنوعية الأحداث التي تمرّ بها تلك الشخصية فإنّ أهميّة الواقعة يضفي شعاعاً من القيمة والاعتبار للمواقف التي تتخذ ضمنها، فكلّما ازدادت دائرة وسعة تلك الأحداث كلّما ازدادت خطورة تلك المواقف وأهميّتها، ومن الواضح أنّ بعض الظروف والأحداث لها نحو من العمومية والاتّساع بحيث لا يحدّها المكان ولا الزمان، كنهضة الإمام الحسين× التي يمتدّ شعاعها ومبادئها وقيمها في عمود الزمان ولكلّ مكان، والتي كان للسيّدة سكينة بنت الحسين× دور فاعل فيها.
إنّ السيّدة سكينة كان لشخصيتها ومواقفها الدور الكبير في إحياء نهضة عاشوراء؛ لأنّها من بيت القيادة وبنت الحسين بن علي بن أبي طالب^، هذه الشخصية تستحق البحث لأكثر من سبب، فقد مثّلت المواقف الصحيحة والمنضبطة والشرعية والشجاعة قبال الظروف الصعبة التي مرّت بها أثناء واقعة عاشوراء وما بعدها، فهي قد رسمت للأجيال الطريق الصحيح والواقعي في مثل تلك الظروف والوقائع، وهي حَريّة بالاتّباع والانتفاع والاستفادة، فهي مربية ومعلّمة ودليل إلى الحقيقة. هذا بالإضافة إلى أنّ أمثال هذه الشخصيات تستحق بذاتها البحث والمتابعة والكتابة كونها تشكّل رمزاً للإسلام بل وللإنسانية، ومحلاً للافتخار والاعتزاز.
إنّ شخصية السيّدة سكينة والدور الذي أدّته وقامت به على أفضل وجه لا ينتهي البحث عنه، بل لا بدّ أن يستمر وبشكل متواصل ومن خلال دراسات وبحوث متنوّعة، فهي قامت بمواقف خالدة يمكن أن نستنطقها في مجالات واسعة وظروف متغيرة، كما أنّ هكذا شخصية لم ولن تسلم من أقلام المغرضين والمشككين لغايات عديدة ومتنوّعة، مما يحتّم دفع تلك الإشكالات والشبهات كلّما أثيرت من هنا أو هناك، وهو ما يستدعي الاستمرار والبحث. فإنّ ما قامت به الباحثة في هذه الرسالة هو خطوة جادّة ومحاولة ناجحة في بيان حياة السيّدة سكينة ومواقفها الخالدة ودفع الإشكالات والشبهات التي تثار حولها بشكل علمي مدروس ومنظّم. وقد كان للّجنة العلمية في قسم الرسائل والأطاريح في مؤسسة وارث الأنبياء دور مميّز في إيصال الرسالة إلى ما هي عليه الآن.
نسأل الله تعالى للمؤلِّف دوام السَّداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا إنَّه سميعٌ مجيبٌ.
اللجنة العلمية في
مؤسسة وارث الأنبياء
للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية
مقدمة
مقدمة قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه، وأشرف بريته محمّد وآله الطيبين الطاهرين.
سيبقى الإمام الحسين× مابقي الدهر عنواناً للتضحية، ورمزاً للوفاء، وشعاراً للفروسية والإقدام، وقبلة للأحرار، وستبقى نهضته الخالدة شمساً مشرقة في سماء الفتوحات الربانية، ونجماً ساطعاً للباحثين عن الطموح الرفيع، وأفقاً مضَمَّخاً بدماء الشهداء الذين دوّنوا تاريخ الإنسانية بأقلام من نور على صحائف من ذهب.
ولم تكن السيّدة سكينة بنت الحسين÷ ـ والتي هي موضوع هذه الدراسة التاريخية ـ غائبة عن حدث الطّف المريع الذي ارتكب فيه خصوم الإسلام أبشع الجرائم في تاريخ البشرية، بما في ذلك الذبح والأسر، والنهب والتمثيل، وانتهاك الحرمات، وقتل النفس المحترمة، بل كانت‘ في وسط الواقعة تمثِّل جزءاً منها، وكانت شاهدة على عصرها، مشاركة في أحداثه، بما كان لها من مواقف، وماقامت به من أدوار رفعت اسمها عالياً على مرِّ الحُقب وتتابع الأجيال.
لقد حاولت الباحثة الكريمة في هذه الرسالة ـ المعنونة (السيّدة سكينة بنت الحسين÷، دراسة تاريخية) ـ مساءلة التاريخ واستنطاقه؛ للبوح والإفصاح عن سيرة حفيدة نبي الإسلام محمدﷺ، وفلذة كبد سيد الشهداء الإمام الحسين×، في سعي دؤوب لتسجيل الحقائق، ودفع الشُّبُهات التي ساقها بعض الكتبة، وحملة أقلام الزيف والإثارات، وربما الضغائن لآل البيت النبوي الشريف، رغم ندرة المصادر وشحّة المراجع حول حياة وشخصية السيّدة سكينة‘، فخرجت الدراسة في مقدِّمة، وثلاثة فصول استقصت فيها الباحثة مكوّنات الهوية الشخصية للسيّدة سكينة‘، فتحدَّثت عن اسمها ولقبها ونسبها، ونشأتها وتربيتها، وعبادتها وزهدها، ووفاتها ومشهدها، وهل هو في الشام بمقبرة الباب الصغير، أو في مصر بحي الخليفة بالقاهرة؟
كما تناولت صاحبة هذه الدراسة العديد من مواقف وأدوار السيّدة سكينة‘ في واقعة الطف، كموقفها من استشهاد علي الأكبر والعبّاس÷، وموقفها من أزمة العطش، ومن استشهاد الطفل الرضيع، ومن وداع واستشهاد أبيها الحسين×، وموقفها من همجية الأعداء والسَّلب والنهب، وحرق الخيام، ثمّ توقَّفت عند دورها‘ في مجلس يزيد بن معاوية، وفي المواجهة والإحتجاج، وعند الرجوع إلى كربلاء، وفي إحياء النهضة الحسينية، ودورها في المجالَين الثقافي والفكري. ثمّ أنهت دراستها بردِّ الشُّبُهات التي أوردها البعض حول السيّدة سكينة‘ من قبيل شبهة تعدُّد الزيجات، وشبهة المشاركة في مجالس الشعر والغناء، وغير ذلك من الإفتراءات التي لاصحة لها، ولابرهان عليها.
وبغضِّ النظر عن بعض التعديلات ـ التي أدخلتها اللجنة العلمية في قسم الرسائل والأطاريح الجامعية في مؤسَّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية، كتلك التي أُدخِلت حول هيكلية البحث، وتغيير عناوين بعض الفصول، ودمج بعض العناوين الفرعية، والتغلُّب على بعض المشكلات اللغوية والعروضية والمضمونية ـ فإنَّ هذه الرسالة تستحقُّ الإهتمام والمطالعة، وتشكِّل إضافة ملموسة لذخائر البحوث والدراسات في مكتبات الحوزات، والجامعات، والأكاديميات، والمعاهد العلمية.
قسم الرسائل والأطاريح الجامعية
المقدِّمة وتحليل المصادر
الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمّد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
وبعد، لقد كانت واقعة كربلاء وصمة عار على جبين الأمَّة التي سوَّلت لها نفسها قتل ابن بنت نبيها، سيد شباب أهل الجنّة، وأهل بيته، وسبي عياله، وستبقى الأمَّة تتحمَّل وزرها إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى: (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)([8]).
إنَّ الأمّة عندما تُبتلَى بمثل هذا الواقع وتعيش في أتون مثل هذه الحالة، فإنَّ سُنَّة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يصطفي ـ بين الحين والآخر ـ بعض ذوي النفوس العالية، والأرواح السامية؛ ليضرب بها الأمثال، تارة في قوة الإيمان وصدق اليقين، وأخرى في الصبر على البلاء؛ ليتذكَّر النّاس مواقفهم الباهرة وسِيَرِهم العطرة، ويُدركوا ما يمكن أن يحقِّق الإيمان من إعجاز، سواء انتصر مثل أولئك المصطفَين المختارِين، أم استُشهِدوا وخُلِّدوا في سجلِّ التاريخ.
ومن أروع صفات الخلود وقفة الإمام الحسين× في واقعة كربلاء بوجه حاكم طاغ؛ فكان هدف بني أميّة في مجزرة كربلاء إبادة العترة الطاهرة عِدل القرآن، وعلم الله، ومحطِّ رسالته، وخزّان وحيه بعد جدِّهم رسول الله|، فحاولوا أن يمحوا الإسلام؛ لتعود الأمّة إلى جاهليتها الأولى.
إنَّ واقعة كربلاء لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، ولم تشهد الإنسانية مثلها على مرِّ العصور، ومع ذلك لم يكتفوا بارتكاب تلك الأفعال، بل عمدوا إلى بذل الأموال للوضع وتحريف التفاسير، وتغيير السُّنَن، وتبديل الأحكام، وتشويه سمعة الشخصيات المؤمنة والصالحة، ومنهم السيّدة سكينة التي ظلمها التاريخ والنّاس، كما ظلما أهل بيتها من قبل، فلم تُتَرجَم سيرتها وحياتها كما تقتضيه الأمانة التاريخية.
أهمية الموضوع
إنَّ موضوع البحث عن حياة السيّدة سكينة‘ يستلزم البسط والإيضاح لما أُحيط بتاريخ حياتها من أمور ظالمة؛ إذ أهمل المؤرِّخون الرسميون ذكر الكثير من مواقعها المشرفة ذات المغزى المشرِّف، بل ذكروا مجموعة مفتريات وأكاذيب حول سيرتها، وقد سبق وأن ردَّ على هذه المفتريات جماعة من العلماء الأعلام وألَّفوا كتباً، إلاّ أنَّ تلك الردود كانت عاطفية أكثر ممّا هي تاريخية، ولذلك فالموضوع بحاجة إلى مزيد من التحقيق، وتسليط الأضواء؛ لبيان الأسباب والدوافع لتلك المفتريات والتأويلات.
اختيار الموضوع
وعلى الرغم من الصعوبات والمعوِّقات والمعارضات الكثيرة، اخترت موضوع السيّدة سكينة‘ موضوعاً لبحثي، ولقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع رغبتي في الكتابة عن رمز من رموز النساء، ولاسيما آل البيت^.
صعوبات الموضوع
ليس من السهولة عرض سيرة حياة شخصية لا نجد لبدايتها أو خاتمتها ما يروي ظمأ الباحث من روايات تاريخية صادقة، ممّا يضطرُّه أن يقرأ ما بين السطور ليستشفَّ شيئاً عن تلك الشخصية، فيُصدَم بما حُرِّف، وما أُخذ من الروايات التاريخية في سعي حثيث لتشويه تلك الشخصية، وصولاً إلى تشويه البيت الذي انحدرت منه، ممّا يحول دون الوصول إلى الحقائق كاملة، والتي تمثّل هدف الباحث الذي يسعى إلى تحقيقه، ومن السهل على أيِّ باحث أن يبحث في أيِّ شخصية تاريخية، إلاّ أنَّ البحث في مثل هذا الموضوع ليس من السهولة بمكان ؛ وذلك بسبب الصعوبات التي تواجه الباحث في مثل هذه الدراسات؛ لأنَّ الكثير من مؤلَّفات المؤرِّخين الذين عاشوا في الحقبة الأموية بصورة عامّة فُقِدت وحُرِّفت نصوصها الأصلية، فأصبح الباحث ما بين الحقيقة والخيال، ولا شكَّ أنَّ هذه الحالة تتطلَّب جهداً كبيراً في تمحيص الروايات وتثبيت الحقائق العلمية التي تنصف آل البيت، وتبرز جهودهم في خدمة الإسلام، ومقارعة الظلم والطغيان الأموي.
نطاق البحث وتحليل المصادر
لقد قُسِّمت الدراسة إلى مقدِّمة وثلاثة فصول، رُتِّبت فيها الأحداث التاريخية ترتيباً زمنياً، ضَمَّ مراحل حياتها كافة، ومن هنا جاء الفصل الأول مبيِّناً اسمها ولقبها واختلاف الآراء حولهما، وعراقه نسبها، موضِّحاً أصالة تلك الأسرة الطاهرة، وكيف اصطفاها الله تعالى من دون سائر النّاس بدلائل (الآيات والأحاديث)، وتاريخ ولادتها، على الرغم من شحّة المصادر التاريخية التي تناولت سيرة السيّدة سكينة كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى.
أمّا الفصل الثاني فقد ضمَّ دور السيّدة سكينة‘ بداية من واقعة الطف، ودورها في مواجهة الدَّسِّ والتزييف الإعلامي الذي بثَّتهُ السلطة الأموية في صفوف أهل الشام، ثمّ تسليط الضوء على دورها في إكمال رسالة السيّدة زينب‘، وكيف أكملت باقي حياتها الشريفة منقطعة إلى الله تعالى، عابدة قانتة، لم تُشفَ من جراح واقعة الطّف إلى الأيام الأخيرة من حياتها، كما تناولت مكان دفنها، مستعرضة الآراء التي اختلفت حول مكان دفنها.
وأمّا الفصل الثالث فقد ضمَّ الردَّ على الشُّبُهات التي وردت حول السيّدة سكينة‘؛ بدءاً من شُبُهات زواجها أكثر من رجل، وشُبُهات المجالس الأدبية والغناء، مبيِّنة أنَّ كلَّ ما كُتِب حول السيّدة سكينة هي أقلام مبغضة لأهل البيت^ مستخدمة العرض التاريخي للروايات، ومن ثمّ الردّ عليها، مبينة الأساليب ودوافع تلك الأقلام، ومبينة حال رواة تلك الروايات.
وفي الخاتمة أوضحتُ أهمَّ النتائج التي توصَّل إليها البحث، وأعقبته بقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذه الرسالة، فكانت خاتمة المطاف مع ملخص للرسالة باللغة الانجليزية.
وقد اعتمدت في رسالتي هذه على الكثير من المصادر الأولية، والمراجع الثانوية، فكان القرآن الكريم أحد أهمِّ المصادر الرئيسية التي لا غنى لأيِّ باحث عنه، وخاصة عندما يكون الموضوع خاصّاً بأهل البيت^.
ومن تلك المصادر:
أ ـ كتب التفسير
من كتب التفسير التي استخدمتها في الرسالة:
1ـ الثعلبي (ت427هـ/1035م): الكشف والبيان عن تفسير القرآن.
2ـ الواحدي (ت468هـ/1075م): أسباب نزول القرآن والوسيط في تفسير القرآن المجيد.
3ـ البغوي (ت510هـ/1116م): معالم التنزيل في تفسير القرآن.
4ـ ابن عطية الأندلسي (ت542هـ/1147م) :المحرر الوجيز.
5ـ السيوطي (ت911هـ/1505م): الدُّرُّ المنثور في التفسير بالمأثور.
ب ـ كتب الأحاديث النبوية الشريفة
لقد اعتمدت في رسالتي على مجموعة من كتب أحاديث النبيﷺ في حقِّ أهل البيت^، ومن تلك الكتب:
1ـ الطيالسي (ت204هـ/819م): مسند أبي داود الطيالسي.
2ـ ابن أبي شيبة (ت235هـ/849م): المصنَّف في الأحاديث والآثار.
3ـ ابن راهويه (ت238هـ/825م): مسند إسحاق بن راهويه.
4ـ ابن حنبل(ت241هـ/855م): فضائل الصحابة ومسند الإمام أحمد بن حنبل.
5ـ النيسابوري (ت261هـ/874م): المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسل اللهﷺ.
6ـ الترمذي (ت279هـ/892م): الجامع الكبير (سُنَن الترمذي).
7ـ النسائي (ت303 هـ/915م): السُّنَن الكبرى.
ج ـ كتب التراجم والطبقات
لقد اعتمدت في رسالتي على عدد كبير من كتب التراجم والطبقات، ومنها:
1ـ ابن سعد (ت230هـ/785م): الطبقات الكبرى.
2ـ خليفة ابن خيّاط (ت240هـ/854م): طبقات خليفة بن خيّاط.
3ـ ابن حِبّان (ت 354هـ/965م): الثقات.
4ـ الثعالبي (ت 630هـ/1038م): يتيمة الدهر في مجالس أهل العصر.
5ـ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م): أُسد الغابة في معرفة الصحابة.
6ـ الذهبي (ت748هـ/1347م): تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام.
7ـ الصَّفَدي (ت764هـ/1363م): الوافي بالوفيات.
8ـ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ/1448م): نزهة الألباب في الأعقاب.
د ـ كتب الأدب
لقد استخدمت مجموعة من كتب الأدب، ولاسيما في الفصل الثاني؛ لكونه يتعلّق بالمجالس الأدبية، ومن تلك الكتب:
1ـ ابن قتيبة الدينوري (ت276هـ/889م): عيون الأخبار.
2ـ ابن عبد ربّه (ت328هـ/940م): العقد الفريد.
3ـ أبو الفرج الأصفهاني (ت356هـ/967): الأغاني.
4ـ المرزباني (ت384هـ/994م): الموشّح في ما أخذ العلماء على الشعراء.
5ـ القيرواني (ت453هـ/101م): زهر الآداب وثمر الألباب.
6ـ ابن رشيق (ت463هـ/1071م): العمدة في محاسن الشعر وأدبه.
7ـ الزوزني (ت486هـ/1093م): شرح المعلّقات السبع.
8ـ ابن منقذ (ت584هـ/1188م): البديع في نقد الشعر.
9ـ ياقوت الحموي (ت626هـ/1229م): معجم الأدباء.
10ـ النويري (ت733هـ/1333م): نهاية الإرب في فنون الأدب.
هـ ـ كتب البلدان
لقد استعملت بعض كتب الجغرافية والبلدان، وقد أغنت الرسالة منها:
1ـ اليعقوبي (ت292هـ/905م): البلدان.
2ـ ناصر خسرو (ت481هـ/1088م): سفر نامة.
3ـ أبو عبيد (ت487هـ/1093م): معجم ما استُعجِم من أسماء البلاد والمواضع.
4ـ الزمخشري (ت538هـ/1143م): الجبال والأمكنة والمياه.
5ـ ياقوت الحموي (ت626هـ/1229م): معجم البلدان.
6ـ القزويني (ت682هـ/1283م): آثار البلاد وأخبار العباد.
7ـ ابن عبد الحقّ (ت739هـ/1338م): مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع.
و ـ كتب اللغة
من أهمِّ كتب اللغة التي اعتمدت عليها:
1ـ ابن دريد (ت321هـ/933م): جمهرة اللغة.
2ـ الجوهري (ت393هـ/1002م): الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.
3ـ ابن سيّدة (ت458هـ/1065م): المخصّص.
4ـ ابن منظور (ت711هـ/1311م): لسان العرب.
كما اعتمدت على مجموعة كبيرة من المراجع الثانوية التي أغنت الرسالة، ذكرتها في قائمة المراجع الثانوية، منها:
1ـ المقرّم، عبد الرزاق الموسوي: السيّدة سكينة ابنة الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين×.
2ـ الهاشمي، عبد المنعم، السيّدة سكينة‘.
3ـ بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن: سكينة بنت الحسين÷.
4ـ الحلو، محمّد علي: عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقَّبة سكينة.
الفصل الاول: سيرة السيّدة سكينة واسرتها
أولاً: اسمُها
لقد أثبت أرباب السِّير والتاريخ اختلافاً في اسمها ما بين آمنة وأمينة وأميمة، واتفقوا على أنَّ سكينة لقب عُرِفت به([9]).
وفي رواية عن محمّد بن السائب([10]) قال: «سألني عبد الله بن حسن([11])عن اسم سكينة ابنة الحسين×؟ فقلت: أميمة. فقال: أصبت»([12]).
يرى الحلو عدم استبعاد التصحيف([13]) في هذه الرواية، حيث جاء فيها أميمة بدل آمنة، وقول عبد الله بن الحسن أصبت لآمنة لا أميمة([14]).
وبعد أن ذكر الحلو أنَّ غاية عبد الله بن الحسن هو تصحيح، والتأكيد عليه بأنَّ اسمها آمنة وليس سكينة؛ قال: «وتأكيد عبد الله بن الحسن على محمّد بن الكلبي له خصوصيته؛ فإنَّ ابن الكلبي كونه نسابة، وعبد الله بن الحسن حريص على تصحيح الاسم بواسطة محمّد بن الكلبي؛ لرجوع النّاس اليه»([15]).
وذكر أبو الفرج الأصفهاني أنّ اسم سكينة أُميمة، وقِيل: أمينة وقِيل: آمنة، وسكينة لقب لُقِّبت به. وروي أنَّ رجلاً سأل عبد الله بن الحسن بن الحسن عن اسم سكينة فقال: أمينة، فقال له: إنَّ ابن الكلبي يقول أُميمة، فقال: سَل ابن الكلبي عن أُمِّه، وسَلني عن أُمِّي. وقال المدائني([16]): حدثني أبو إسحاق المالكي قال: سكينة لقب، واسمها آمنة، وهذا هو الصحيح([17]).
كما وجدت اختلافاً آخر في الاسم؛ فيقول ابن عساكر في ترجمة لسكينة‘: «ويُقال آمن بنت الحسين»([18])، أمّا السيد الأمين فنقل عدداً من الأقوال، وذكر أنَّ الصحيح عند المدائني هو اسم: آمنة ([19]).
بعد العرض للروايات التاريخية ترى الباحثة أنَّ الأسماء تعدَّدت، لكنَّ المسمَّى واحد، وهذه ظاهرة اشتهرت بها بنات الحسين× لدرجة عُرِف بكثرة بناته على حدِّ قول الخلخالي: «إنَّ الذي يراجع الكتب والأقوال المختلفة يجد أنَّ البنات اللاتي نُسِبنَ إلى سيد الشهداء ثمانية هنَّ: فاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى، وزبيدة، وزينب، وسكينة، ورقية، وأُمّ كلثوم، وصفية»([20])، بينما بنات الإمام الحسين× هنّ: فاطمة، وسكينة ([21])، لكن البيهقي يذكر أنّ للإمام الحسين× ثلاث بنات هنّ: فاطمة، وسكينة، ورقية([22]).
وقد أضاف أبو سعيدة: زينب، وأمَّ كلثوم، ويعلِّق عليهنَّ: أمّا زينب وأمُّ كلثوم فقد درجتا في عمر الطفولة المتقدمة؛ لذا لم يجدوا جدوى من ذكرهما، أو أنَّ أُمَّ كلثوم هي رقية، لكن غلبتْ كنيتُها على اسمِها([23]).
ومهما اختلفت الأقوال فلم تصل إلى أكثر من أربع بنات للإمام الحسين×؛ ومن هذا المنطلّق فإنَّ أرجح ما ذهب إليه المقرّم هو أنَّ اسمها آمنة؛ وذلك لكون كلِّ الأسماء التي ذكرتها المصادر(أمنة وأمينة وأميمة وآمن)، والثلاثة الأُخر هي تصحيف لاسم آمنة([24]).
ثانياً: لقبها
لقد اتُفِق على أنَّ سَكِيْنَة هو لقب عُرِفت به آمنة بنت الإمام الحسين÷، وقد أطلقته أُمُّها الرَّبابُ بنت امرئ القيس عليها؛ لسكونها وهدوئها([25]).
وسكينة من سكن سكوناً، ويقال: تؤنَّث وتذكَّر؛ فلو أُنِّث الفعل فإنّها تأتي بثلاث لغات:
1ـ سُكَيْنِة: بضمِّ السين، وفتح الكاف، وكسر النون، وتعني: الحمار الخفيف السريع([26])، ولقد خُصَّ بالحمار الوحشي([27]).
2ـ سُكَيْنَة: بضمِّ السين، وفتح الكاف، وسكون الياء، وفتح النون؛ وتعني البقَّة التي دخلت في أنف نمرود بن كنعان الخاطئ فأكلت دماغه (حصراً)([28]).
3ـ سَكِيْنَة: بفتح السين، وكسر الكاف، وسكون الياء، وفتح النون؛ ويُراد بها الوداعة والوقار والأمن، وقيل: هي الرحمة والطمأنينة والوَقار([29]).
ولقد ذُكرت سَكِينة في ستة مواضع في القرآن الكريم، وكلُّ سَكِينة في القرآن هي الطمأنينة، إلاّ التي في سورة البقرة، فإنَّها شيء كرأس الهِرَّة له جناحان([30]). ولم تذكر المصادر هذا الشيء بالتحديد، والمواضع هي:
1ـ (وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ)([31]).
2ـ (ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ)([32]).
3ـ (فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ)([33]).
4ـ (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ)([34]).
5ـ (فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا)([35]).
6ـ (فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ)([36]).
وبعد العرض لفعل سكن يتّضح أنَّ السيّدة سَكينة بالفتح يُعطِي معنى الهدوء والسكون.
ويرى السيد الصدر: «اسمها ليس مصغَّر سَكينة.. وإنما هو مُكَّبر سَكينة مأخوذ من القرآن الكريم: (فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ)([37])، ويعني هي السكينة النازلة تشبيهاً، وأمّا المصغَّر فهو أنثى الحمار، وهذا ما يجهله المثقَّفون والمتفقِّهون من النّاس، ولا يُحتمَل أنَّ الحسين× يجهله»([38]).
أمّا بنت الشاطىء فترى: «أنَّ الرَّباب لقَّبتْها بذلك، لعلَّها لاحظت أنَّ نفوس آلها الأكرمين كانت تسكن إليها»([39]).
ترى الباحثة أنَّ هذا اللقب لم يأتِ من فراغ، بل كان الهدوء والوقار ملازماً للسيّدة منذ طفولتها، لدرجة غلبَ اللَّقبُ على الاسم.
ثالثاً: نسبها
تعود في النسب إلى خاتم الأنبياء محمد|، فهي حفيدة خاتم النبيين، بل أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو القائل: «إلاّ وإنّي سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»([40])، وهو أوّل من تنشقُّ عنه الأرض وأوّل من يشفع([41]).
إنَّها حفيدة نبي الرحمة الذي فُتحت أبواب الجنان لقدميه، فيقول|: «أنا أوّل مَن يقرع باب الجنّة»([42]).
نشأت في حجر النبوّة والإمامة، فنسبها كريم؛ إذ أعزَّ الله به العرب والمسلمين وجعله رحمة للعالمين.
ومن هذا المنطلق نبدأ الحديث عن نسب السيّدة وحسبها، فقد انحدرت من أشرف حسب وأجلِّ نسب، وانتمت إلى أفضل عائلة في التاريخ، وهذا يعني امتلاكها لأعلى درجة من القابلية والإستعداد لتقمُّص رِداء الفضيلة، وتسنّم ذروة المجد، وقد انطبق ذلك الإستعداد فعلاً وسلوكاً على حياتها وسيرتها.
وقبل الدخول في تفاصيل النسب لابدّ لنا من تعريف مصطلح آل البيت وبيان دلالته.
وقبل تعريفه لغة لابدّ من الإشارة إلى أنَّ أصلَ (آل): (أهلٌ)، والألف هنا مبدَلة من الهاء؛ والدليل عليه إذا صَغّرْتَ (آل) قلت: أُهَيْل، والجمع أهلون([43]).
ومن هذا المنطلق يُحدَّد المفهوم اللغوي لكلمة أهل بما يضاف إليها؛ فمثلاً أهل الرأي هم الفقهاء الذين كانوا يتوسَّعون في الاستنباط والقياس، وأهل العلم هم العلماء، وأهل الكهف أصحابه([44]).
فأهل الرجل مَن يجمعه وإيّاهم نسبٌ أو دِينٌ([45])، أمّا أهلُ بيت الرجل فهم أقاربه لأنّهم أكثر مَن يتبعه([46]).
أمّا اصطلاحاً: فهم علي وفاطمة والحسن والحسين^، ودليل ذلك ما نزل في القرآن الكريم من آيات، وما رُوي عن الرسول| من أحاديث بحقِّ آل البيت^، وسنُقدّم استعراضاً لهذه الدلائل:
الآيات القرآنية
أـ (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)([47])، وتُسمَّى هذه الآية بآية التطهير، والمراد بأهل البيت الذين نزلت فيهم هذه الآية هم: محمد| وعلي وفاطمة والحسن والحسين^، على اختلاف بسيط في الروايات.
فعن أمِّ سلمة ([48]) قالت: «بينما رسول الله في بيتي يوماً... فقال لي: قُومي فتنحَّي لي عن أهل بيتي، قالت: فقُمتُ في البيت فدخل علي وفاطمة والحسن والحسين وهما صبيان صغيران، فوضعهما في حجره فقبَّلهما، واعتنق علياً بإحدى يديه، وفاطمة باليد الأخرى، فقبَّل فاطمة، فأغدق عليهم خميصة ([49]) سوداء، فقال: اللهمَّ إليك لا إلى النّار أنا وأهـل بيتي»([50]).
وفي رواية لأمِّ سلمة أنَّ النبيَّ غطّى على علي وفاطمة والحسن والحسين^ كساءً ثمّ قال: هؤلاء أهل بيتي إليك لا إلى النار، قالت أمُّ سلمة: فقلت: يا رسول الله وأنا منهم؟ قال: لا، وأنتِ على خير([51])، هؤلاء أهل بيتي، اللهمَّ أهلي أحقُّ([52]).
وفي رواية عن عائشة ([53]) قالت: «خرج النبي| من عندي وعليه مُرط([54]) من شعر أسود، قالت: فجاء الحسن فأدخله معه، ثمّ جاء الحسين فأدخله معه، ثمّ جاءت فاطمة فأدخلها معهم فيه، ثمّ جاء علي فأدخله، ثمّ ضمَّ عليهم المُرط، ثمّ قال: اللهمَّ هؤلاء أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهِّرهم تطهيراً»([55]).
كما يقول الواحدي: «آية التطهير نزلت في خمسة: النبي| وعلي وفاطمة والحسن والحسين»([56]).
كما يلحق هؤلاء الخمسة الذرية الطاهرة، وهم الأئمة التسعة المعصومون من ولد الإمام الحسين×، وهم أقرب النّاس إلى النبي|، وأخصّهم من حيث العلم، وهؤلاء الإثنا عشر مكانهم في الجنّة ([57]).
وفي رواية عن الإمام علي× عندما نزلت آية التطهير قال: «قال رسول الله|: يا عليُّ! هذه الآية نزلت فيكَ، وفي سِبطَيَّ، والأئمّة من ولدك»([58]).
كما صرَّح بصحَّة الحديث ابن تيمية؛ حيث قال في حديث الكساء: «إنَّ النبي| أدار الكساء على عليٍّ وفاطمة والحسن والحسين، ثمّ قال: هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس، وطهِّرهم تطهيراً. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة، ورواه أهل السُّنَن عن أُمِّ سلمة»([59]).
والمهمُّ من عرض الروايات إثبات أنَّ سكينة هي بنت أحد أصحاب الكساء، الذين أذهب الله عنهم الرِّجسَ وطهَّرهم تطهيراً.
ب ـ (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)([60]).
هذه هي آية المودَّة التي أكَّدت أغلب كتب التفسير، ومصادر الحديث، والسير والتاريخ، نزولها في قربى النبي|، وهم عليٌّ والزهراءُ والحسنُ والحسين^ وذريَّتُهم الطاهرون^.
فقد رُوي في تفسير هذه الآية بالإسناد إلى ابن عبّاس قال: «لمّا نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله، مَن قرابتُكَ هؤلاء الذين أوجبتَ مودَّتَهم؟ قال: عليٌّ وفاطمة وولداها»([61]).
وعن الإمام علي بن أبي طالب×: «قال رسول الله|، عليكم بتعلُّم القرآن، وكثرة تلاوته؛ تنالون به الدرجات العُلى، وكثرة عجائبه في الجنّة، ثمّ قال علي×: وفينا في الرَّحم آية، لا يحفظ مودَّتنا إلاّ كلُّ مؤمن، وقرأ الآية: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) ([62])» ([63]).
ج ـ (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)([64]).
لقد أكَّدت كتب التفسير والتاريخ أنَّ هذه الآية تُسمَّى المباهلة ([65])، ولقد جاء هذا الخطاب الإلهي على أثر المحاجَّة بين الرسول الأكرم| ووفد نصارى نجران([66])، سنة 9هـ/630م([67])؛ حيث ادَّعَوا الحقَّ لأنفسهم، والظهور على الدين، فدعاهم رسول الله| إلى المباهلة بناء على هذه الآية الكريمة، وكان نتيجة ذلك أن ردَّ’ ادِّعاءهم إلى نحورهم، وأفحمهم بالحجَّة، وغلبهم بالبرهان، فاختاروا الموادَعَة، ودفع الجزية ([68])([69]).
لقد أجمعت كتب التفسير على الذين انتخبهم رسول الله| بناء على الأمر الإلهي للآية الكريمة، هم: علي، وفاطمة، والحسن، والحسين^، لا أحد سواهم([70]).
والذي يهمُّنا هنا هو بيان مصاديق هذه الآية الكريمة الذين اصطفاهم الله تعالى لتلك المنازل العظمى، وبيان مدلولات هذا الاختيار الإلهي.
وممّا تقدَّم فإنَّ السيّدة سكينة هي بنت مَن اختاره الله واصطفاه في آية المباهلة.
أحاديث النبي محمدﷺ
أ ـ قوله|: «يا أيُّها النّاس إنِّي تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ فإنَّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض»([71]).
ولقد ورد في هذا الحديث عدَّة صِيغ، ففي رواية قال رسول الله|: «يا أيُّها النّاس إنِّي تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلُّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي»([72]).
وفي رواية أخرى: «إنِّي تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي»([73]).
ب ـ قوله|: «ومثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها هلك»([74]).
ج ـ قوله|: «أدِّبوا أولادكم على ثلاث خصال: حبِّ نبيكم وحبِّ أهل بيته، وقراءة القرآن»([75]).
د ـ قوله|: «أُذكِّركم الله في أهل بيتي، أذكِّركم الله في أهل بيتي، أذكِّركم الله في أهل بيتي»([76]).
ولقد أكَّدت السنَّة النبوية على أنَّ أهل البيت هم أساس الإسلام، لذا فإنَّ الولاء لهم علامة الإيمان، بل أفضل العبادة، وأنَّ حبَّهم حبٌّ لله ولرسوله.
وعن رسول الله|: «أحبُّوا الله لما يغذوكم من نعمة، وأحبُّوني لحبِّ الله، وأحبُّوا أهل بيتي لحبِّي»([77]).
والقراءة للنصوص تبرز لنا أصالة العلاقة بين مبدأ المحبَّة لهم^ وبين الإنتماء للرسالة، بمقدار ما يرتفع هذا المبدأ في شعور الأُمَّة ووجدانها، والأحاديث التالية دليل على ذلك، فقوله|: «حُبُّ آل محمّد يوماً خير من عبادة سنة، ومن مات عليه دخل الجنّة»([78]).
وفي قول للإمام الصادق×([79]): «إنَّ فوق كلِّ عبادة عبادة، وحبُّنا أهل البيت أفضل عبادة»([80]).
لقد أكَّدت الروايات على أنَّ حبَّ أهل البيت واجب، ومَن يحبُّهم يبلغ أعلى درجات الإيمان، وقد حذَّرت من معاداتهم وبغضهم؛ ففي قول للرسول|: «اشتدَّ غضب الله على مَن آذاني في عترتي»([81]).
إذاً فنسبها أشرف نسب؛ لاتصاله بعظيم من العظماء وأشرف الخلق، والمجد يُطلق على الشرف الباذخ، ويُطلق على الكرم والعزِّ والجاه، فذريّة رسول الله ذرية طاهرة، وفي ذلك يقول|: «كلُّ ولد آدم كان عصبتهم لأبيهم، ما خلا ولد فاطمة فإنِّي أبوهم وعصبتهم»([82]).
فعرفنا ـ بحقٍّ ـ نسبها؛ وتقديراً للشجرة الطيبة سنتوقَّف على حلقة نسبها وسنقتصر على جدِّها وجدَّتِها.
هو أفضل النّاس من بعد الرسول محمد|([83])، علي بن أبي طالب بن عبد المطّلب ابن هاشم، سيد الأصفياء وعلم الأتقياء([84])، أُمُّه فاطمة بنت أسد بن عبد مناف، وهي أوّل هاشميّة ولدت هاشميّاً، وهو أوّل من آمن من النّاس بعد خديجة الكبرى([85])، وأوّل من صدَّق رسول الله من بني هاشم([86]). لُقِّب بأمير المؤمنين، ويعسوب الدين والمسلمين، قاتل المشركين، والناكثين والقاسطين والمارقين، مولى المؤمنين، نفس الرسول، أمير البرَرَة، وقاتل الفجَرَة، قسيم الجنّة والنار، صاحب لواء رسول الله’، سيد العرب والعجم وفارسها، والصدّيق الأكبر، وذو القرنين، والهادي والفاروق، وباب مدينة رسول الله’، ومفرِّج الكرب عنه، ووصيّه، وقاضي دينه، ومنجز وعده([87]).
ولقد جُمع له الشَّرف من كلِّ جهة؛ إذ ليس من خصلة شريفة إلاّ وقد خصَّه الله بها، فهو ابن عمِّ الرسول، وأخوه، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وأبو ريحانتَيه الحسن والحسين([88]).
ويقول الخطيب البغدادي عنه×: «ومناقب علي أشهر من أن تُذكَر، وأوسع من أن تُحصَر»([89]).
كما جاء في رواية عن رسول الله| أنّه قال: «ادعوا لي سيّدَ العرب، فقالوا: يا رسول الله ألست سيّدَ العرب؟ قال: أنا سيّدُ ولد آدم، وعلي سيّدُ العرب»([90])، وفي رواية أخرى قال|: «علي سيّد شباب العرب»([91]).
ومن أقوال النبي| في حقِّه يوم خيبر([92]): «لأدفعنَّ الراية إلى رجل يحبُّ اللهَ ورسولَه ويحبُّه اللُه ورسولُه»([93]).
وقول رسول الله|: «لكلِّ نبيٍّ وصيٌّ ووارثٌ، وإنَّ علياً وصيي ووارثي»([94]).
وقول الرسول| للإمام علي عندما استخلفه على المدينة، وخرج إلى غزوة تبوك سنة 9هـ/630م([95])، حيث قال له: «أَمَا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غيرأنَّه لا نبيَّ بعدي»([96]).
وقال النبي| يوم غدير خُمٍّ([97]): «من كنت مَولاه فعليٌّ مَـولاه»([98]).
فاطمة بنت رسول الله|، أمُّها خديجة بنت خويلد، وَلَدَتها وقريش تبني البيت الحرام، وذلك قبل النبوّة بخمس سنين، وحبُّ فاطمة نابع من حبِّ الرسول لها؛ فهي أُمُّ أبيها([99])، وبضعته، وروحه التي بين جنبيه، كان رسول الله يحبُّها حبّاً لا يشبه محبّة الآباء لبناتهم؛ وذلك لما تتمتّع به من الفضائل الفريدة والمواهب والمزايا، فهي ابنة الإسلام الأولى؛ حيث درجت وترعرعت في أحضان النبوّة، وشبَّت في كنف الإمامة، وهي المعصومة من كلِّ دنس وعيب، فكانت المرأة المُثلى في الإسلام، بل هي سيّدة نساء أهل الجنّة على لسان النبي|([100]).
اقترن تاريخها بتاريخ الرسالة، وقد أشاد النبيُّ الكريم بعظيم منزلة الزهراء الطاهرة، لما بلغته من موقع ريادي في خطِّ الرسالة، محتذياً خُطى القرآن الكريم فيما صرَّح به من فضائل ومكرمات لأهل بيت الوحي بشكل عام، وللزهراء‘ بشكل خاص.
لقد مدح القرآن الكريم أناساً خلَّدهم بآيات تُتلى آناء الليل وأطراف النهار؛ إكباراً لمواقفهم، ولتفانيهم في سبيل الحقِّ، ولقد ذُكِرت الزهراء في آية التطهير([101]) والمباهلة ([102]) والشورى([103])، وغيرها.
كما خصَّها الرسول بأقوال منها: «فاطمة بضعة منّي مَن أغضبها أغضبني»([104]).
وقوله|: «سيّدات نساء العالمين: فاطمة بنت محمّد، وخديجة بنت خويلد، وآسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران»([105]).
وفي رواية قال رسول الله| لعلي: «تدري لِمَ سُمِّيت فاطمة ؟ قال علي: لِمَ سميت فاطمة ؟ قال|: الله قد فطمها وذريَّتها من النّار يوم القيامة»([106]).
ولقد «سُئِل الإمام الصادق عن معنى: حيّ على خير العمل، فقال: العمل هو برُّ فاطمة وولدها»([107])، تُوفيت بعد النبي’ ـ على بعض الأقوال ـ بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل([108]).
إذاً هي (السيّدة سَكينة) قرشية هاشمية علوية؛ لانتسابها إلى الإمام علي بن أبي طالب×([109])، ولقد احتفظت بأصالة نسبها، وكسبت الكثير من الصفات التي سنتطرّق إليها لاحقاً، ولاسيما الشجاعة والصبر، والإكثار من العبادة.
وقد ذكرت الروايات أنَّ السيّدة الجليلة كانت تفتخر بنسبها، وكانت النّاس تصمت أمام هذه الشجرة الطيّبة، ولم يستطع أحد أن ينكرها مهما زاد طغيان السلاطين، ففي رواية أنَّ السيّدة‘ حضرت مأتماً فيه بنت عثمان بن عفّان فقالت بنت عثمان: أنا بنت الشهيد، فسكتت سكينة‘ حتّى أذَّن المؤذِّن وقال: أشهد أنَّ محمداً رسول الله، قالت لها سكينة‘: هذا أبي أو أبوك؟ فقالت بنت عثمان: لا أفاخر عليكم أبداً([110]). حيث كفَّت موضع الإنكفاف أدباء مع رسول الله|، فقد كان الأمر والمفاخرة في الدّنيا هزلاً، فجعلته السيّدة سكينة بذكر رسول الله| حجّة على غيرها، فلله دَرُّها من مناظِرة عرفت أنواع الجدل([111]).
وذكر الصَّفدي([112]) أنَّ عائشة بنت طلحة ذات يوم أرسلت جاريتها إلى سكينة ووجدتها في محفل من النساء، فقالت لها: تقول لك سيدتي لمن يشبه هذا ـ تقصد به البدر وقد طلع كاملا ـ وكانت عائشة غاية في الجمال والحسن ، فقالت سكينة‘: إذا أصبحنا ونادى المنادي فتعالي حتّى أجيبك، فلما نادى المؤذِّن أتتها فقالت: هاتي الجواب، فقالت: قولي لسيدتكِ جَدُّ مَن هذا؟ فرجعت إليها وقالت لها ذلك، فقالت عائشة: ما بقي بعد هذا كلام مع سكينة. وهذا الخبر كسابقه يكشف عن سمو ِِّ وقوّة شخصية السيّدة سكينة، ولما لها من نسبها أهميّة كبيرة عند العرب، وأكبر الأنساب العربية تصمت أمام نسب محمّد وآل محمد.
وكما يقول البقاعي: «وأمّا محمّد فقد ملأت ذريته من فاطمة الزهراء‘ الأرض ، وهم الأشراف، مع مبالغة الملوك في قتلهم وخلاء الأرض من نسلهم؛ خوفاً من شرفهم العالي ورفعتهم بالتواضع»([113]).
رابعاً: أسرتها
إنَّ الأسرة إحدى العوامل الأساسية في بناء الكيان التربوي، وإيجاد عملية التّطبيع الإجتماعي، وتشكيل شخصية الطفل، واكتسابه العادات التي تبقى ملازمة له طوال حياته، فهي البذرة الأولى في تكوين النموِّ الفردي وبناء الشخصية، فإنَّ الطفل في أغلب أحواله مقلِّد لأبويه في عاداتهم وسلوكهم([114]).
وكما ذكر الصفّار: «إنَّ حَسَبَ الإنسان ونسبه وانتماءه العائلي له أهمية كبيرة في شخصية الإنسان في نظرة الآخرين إليه؛ فهو عامل مؤثِّر في صياغة نفس الإنسان وتوجيه سلوكه ومسار حياته، وقد أثبتت العلوم الحديثة عبر دراسة الجينات والكروموسومات الموجودة في الخليّة الحيّة ما يخلقه العامل الوراثي من قابلية واستعداد في نفس الإنسان»([115]).
ومن هذا المنطلق فإنَّ السيّدة سكينة تنتسب إلى أسرة علوية أصيلة، استمدَّت الأصالة من حجر النبوّة ومنبع الإمامة، تربَّت هذه الأسرة على تِلاوة القرآن، وأحكام الشريعة، وإقامة الحقّ، ومحاربة الظلم والطغيان.
فإذا أردنا الحديث عن أسرتها وبيئتها التي نشأت فيها لابدّ أن نتكلم عن ربِّ الأسرة والأمِّ والإخوان.
هو الإمام الشريف الكامل سبط رسول الله|، وريحانته من الدّنيا ومحبوبه، أبو عبد الله الحسين×([116])، بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، بن عبد المطّلب ابن هاشم بن عبد مناف، بن قصي القريشي الهاشمي([117])، اسمهُ من أسماء أهل الجنّة، لم يكن قبل الإسلام([118])، ولقد برزت مكانة الإمام الحسين× في مواضع عدَّة من القرآن الكريم؛ لتبيِّن للأمّة الإسلامية مكانة أهل البيت. والإمام الحسين× هو ثالث أئمة أهل البيت الطاهرين، وثاني السبطين، أُمُّه فاطمة الزهراء‘، فهو من أهل البيت المطهَّرين من الرِّجس.
وقد خصَّ الله الإمام الحسين× في الآيات الكريمة من قوله تعالى: (إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا)([119])، حيث نزلت هذه الآيات في علي، وفاطمة، والحسن والحسين^([120]).
كما تضافرت النصوص الواردة عن الرسول| بحقِّ الإمام الحسين× والتي تبرز المكانة الرفيعة التي يمثّلها في الدّنيا، نختارمنها هنا نماذج؛ للوقوف على شيء من مكانة الإمام الحسين×.
كقوله|: «الحسن والحسين ابناي من أحبَّهما أحبَّني، ومن أحبَّني أحبَّه الله، ومن أحبَّه الله أدخله الجنّة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النّار»([121]).
هذا الحديث الشريف دليل واضح على أنَّ حبَّ الحسين× هو الطريق الذي يَقود النّاس إلى الجنّة.
ومن هنا فإنَّ الإمام الحسين× له مكانة كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى، في القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة، لم يستطع التاريخ أن يتجاهلها.
والإمام الحسين× هو وليُّ أمر المسلمين من بعد الإمام الحسن× على لسان النبي محمد|، فعن عبد الله بن جعفر الطيار([122]) قال: «كنّا عند معاوية أنا والحسن والحسين...، ودار بيني وبين معاوية كلام، فقلت لمعاوية: سمعت رسول الله| يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ أخي علي بن أبي طالب أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استُشهد علي فالحسن بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثمّ ابني الحسين من بعده أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا استُشهد فابنه علي بن الحسين، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدركه يا علي، ثمّ ابنه محمّد بن علي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وستدركه يا حسين، ثمّ تكملة اثنى عشر إماماً من ولد الحسين»([123]).
ومن هنا فإنَّه إمام منصوب من عند الله تعالى، منصوص عليه بالإمامة العظمى([124]) والولاية الكبرى([125]) من الرسول|. وهو× علم من أعلام الدين، بذل نفسه للحقِّ والمبادئ والقيم.
استُشهِد× يوم الجمعة العاشر من محرم، سنة إحدى وستين([126]).
لقد كان للإمام الحسين× أثر كبير في نشأة السيّدة سكينة‘؛ لذا فإنَّ هناك علاقة وطيدة بينها وبينه×، وهذا ماسنلاحظه قبل استشهاده. وعليه فقد لعب عامل الوراثة والبيئة والأسرة دوراً مميَّزاً في حياتها.
ب ـ الأمُّ
هي الرَّباب بنت امرئ القيس([127]) بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم بن هبل بن كنانة الكلبية ([128])، تزوَّجها الإمام الحسين× بعد إسلام والدها امرئ القيس.
وقد ذكرت كتب التاريخ قصّة إسلام والدها امرئ القيس، فقد أسلم في زمن خلافة عمر بن الخطاب (13ـ23هـ/634ـ652م)، حيث أقبل رجل مهيب يتخطَّى رقاب النّاس حتّى أقام بين يدي الخليفة، وحيّاه بتحية الخلافة، فقال لَهُ عمر بن الخطاب: من أنت؟ فقال: امرؤ القيس بن عدي الكلبي، فلم يعرفه عمر، فقام رجل من القوم وقال: هذا صاحب بكر بن وائل الذي أغار عليهم يوم فلج([129]) قبل الإسلام، فقال ماذا تريد؟ قال: أريد الإسلام، فعرضه عليه فقبله، ثمّ دعا له برمح، فعقد له على مَن أسلم من قضاعة، فأدبر الرجل واللواء يهتزُّ على رأسه، قال عوف بن خارجة ([130]) ما رأيت رجلاً لم يصلِّ سجدة اُمِّر على جماعة من المسلمين قبله، ثمّ نهض الإمام علي ومعه ابناه الحسن والحسين^، من المجلس حتّى أدركه، فأخذ برأسه، فقال له: أنا علي بن أبي طالب ابن عمِّ رسول الله| وصهره([131])، وهذان ابناي من بنته، وقد رغبنا في صهرك، فأنكحنا، قال: قد أنكحتك يا علي المحياة بنت امرئ القيس، وأنكحتك يا حسن سلمى بنت امرئ القيس، وأنكحتك يا حسين: الرباب بنت امرئ القيس([132]).
فيتّضح لي من هذه الرواية ما يلي:
- أنَّ الرجل حديث الإسلام، ولم يعرفه الخليفة.
- قبول العرض دون تردّد.
- عدم الأخذ برأي بنات امرئ القيس.
ومن هنا يبدأ الخلط التاريخي؛ إذ كيف يَقبل الإمامُ علي× مثلَ هذا الأمر؟! لو نرجع إلى الوراء قليلاً عند زواج الإمام علي× من السيّدة فاطمة الزهراء‘ وهو ابن عمّ الرسول|، قال له الرسول|: أعطِ شيئاً قال: ما عندي شيء، قال| فأين درعك الحطمية([133]) ؟ ([134]).
وهذا يعني جعل اتفاق، وكان هناك مهر للسيّدة فاطمة الزهراء‘، أمّا بخصوص طلب المصاهرة من امرئ القيس فيتّضح لي أمران:
الأول: لم يرد التاريخ والسيرة التشويه على تصرّفات الإمام علي بن أبي طالب×.
الثاني: حصل على موافقة مبدئية، ثمّ تمَّ الإتفاق، وهذا ما أُرجِّحه؛ وذلك للبعد الزمني لخلافة عمر بن الخطاب (13 ـ23هـ/634ـ652م) إلى ولادة السيّدة سكينة، أي كان الزواج مؤجلاً.
أمّا المقرّم فيرى: أنَّ هذه القصّة لا مساس لها بالواقع؛ لأنَّ مَن أمعن في شخصية أمير المؤمنين ـ المتحلّية بالأخلاق الشرعية والعادات المألوفة ـ جَزَمَ بمنافاة إسراعه إلى المصاهرة من النصراني الذي هو جديد عهد بالإسلام، وممّا يبعد القصّة؛ إهمالها اختيار رأي البنات في الرضا، ولعدم تعيين المهر، وتسارع أمير المؤمنين خوف فوات هذا (الكنز) منه لو لم يبادر إلى مذاكرة الرجل في بناته([135]).
ولا نستبعد رأي المقرّم؛ وذلك لأنَّ الرواية رُويت في مواضع من قبل ابن الكلبي وهو متروك الحديث([136])، ورُويت في مواضع أخرى من طريق على بن مجاهد([137])، والإثنان غير ثقتين، ومعروفان بالكذب([138]). أمَّا بخصوص تسرّع الإمام علي× في طلب المصاهرة من امرئ القيس فإنَّ الإمام علياً كان واثقاً من الاختيار، ومطبّقاً قول رسول الله|: «انظر في أيِّ نصابٍ تضع ولدك؛ فإنَّ العِرق دسّاس»([139]).
ذكرت بنت الشاطئ أنَّ الإمام الحسين× كان عمره 18 عاماً عندما خطب السيّدة الرباب، وهذا يعني إسلام امرئ القيس في عام 22هـ/642م، كما تذكر أنَّ السيّدة الرباب تُرِكت لفترة في بيت أبيها؛ وذلك لصغر سنِّها الذي حال دون التعجيل بالزواج، كما تذكر خروج الإمام الحسن والحسين÷، مع عبد الله بن سعد بن أبي سرح([140]) في غزوة على بلاد افريقية، بقوا عاماً وبعض العام، ثمّ عادوا من المدينة منصورين، وتمَّ زواج الحسين× من الرباب([141]).
وهذا يعني أنَّ خروجهم كان في 27هـ/647م، وبقوا عاماً أو أكثر أي في عام(28 أو 29/648ـ649م) تمَّ الزواج، ومن عام 28إلى (42هـ/648ـ662م) تاريخ ولادة السيّدة سكينة، فهناك فرق شاسع وهو14 سنة أو أكثر، وإذا كان الزواج قبل هذا التاريخ، أي بعد ستِّ سنوات يعني تكون المسافة أطول.
فعلى هذه الرواية الخطبة بعيدة كلّ البعد عن واقع الحال، كما أنَّها مشكوك في أمرها وذلك لضعف رواتها؛ فقد وردت عن طريق علي بن مجاهد وابن الكلبي كما مرَّ، وعدم تناسب القصّة بمكانة الإمام علي×، وعدم التناسب الزمني للرواية بالأحداث التاريخية.
وكلُّ من يقرأ ترجمة السيّدة الرباب يجد بيتين شعريين أو أكثر من ذلك، زعم المؤرخون أنَّ الحسين بن علي÷ قالهما بحقِّ زوجته وبنته سكينة، وكان× يحبُّهما كثيراً إذ يقول:
|
لَعمرُكَ إنَّني لأحبُّ داراً |
كما ذُكِر هذا الشعر بصيغة بيتين عند بعض المؤرِّخين:
|
لَعمرُك إنَّني لأحبُّ داراً |
كما ذكر المؤرِّخون بيتاً واحداً فقط:
|
لَعمرك إنَّني لأحبُّ داراً |
يقول المرعشي: إنَّ الحسين× قال هذه الأبيات تكريماً لابنته سكينة، وذكر بيتاً آخر:
|
كأنَّ الليلَ موصولٌ بليلٍ |
يرى المقرّم بخصوص الأبيات الشعرية، هذا جهلاً بمقام الإمامة، وإغضاءً من ناحية العصمة، وخفوقاً على جهة الشهامة والحفاظ؛ لأنَّ الإمام المنصوب من قبل الله تعالى ـ وهو معصوم من كلِّ خطأ ـ لا يمكن أن يصدر عنه ما يوجب العتاب، فهذا خارج عن الحدود الشرعية، ولا يُعقل صدور مثله عن الحسين×([146]).
أمّا القرشي فيقول: «إنَّ هذه الأبيات فيما نحسب من المنتَحَلات والموضوعات؛ فإن الإمام الحسين× أجلُّ شأناً، وأرفع قدراً من أن يذيع حبَّه لزوجته وابنته بين النّاس، فليس هذا من خُلُقه، ولا يليق به، إنَّ ذلك من دون شكٍّ من المفتريات التي تُعُمِّد وضعها للحطِّ من شأن أهل البيت^»([147]).
تتفق الباحثة مع هذا الكلام، وتشكِّك في مصداقية الأبيات؛ تبعاً لمقوِّمات النقد الأدبي، يقول الطاهر: «ولابدّ من الوقفة الطويلة عند النصِّ؛ لإدراك أبعاده، وبلوغ أعماقه، ومن ثمّ العودة إلى القارئ بالنتائج»([148]).
ومن هذا المنطلق فإنَّ الشعر جاء بصورة مختلفة في الروايات، تارة بيت، وتارة أخرى بيتان، ووصل إلى أربعة أبيات، كما أنَّ هناك اختلافاً واضحاً في صياغة الشعر:
البيت الاول
البيت الثاني
|
أحبُّهما وأبذل بَعْدُ مالي |
البيت الثالث
|
ولَستُ لهم وإن عتبوا مطيعاً |
كما ذكر البلاذري البيتين وقال أيضاً:
|
أُحبُّ لحبِّها زيداً جميعاً |
وقال أيضاً: «الربابُ([156]) هذه بنت أُنيف بن حارثة بن لام الطائي»([157]).
أما ابن كثير فيقول: «أنشد الحسين في زوجته الرباب بنت أُنيف، ويُقال الرباب بنت امرئ القيس:
|
لَعمرُك إنَّني لأحبُّ داراً |
وهذا دليل على وجود خلط تاريخي، وعند قراءة الأبيات الشعرية يتّضح لي أنَّ هناك حبَّاً وإعجاباً شديداً، وهذا ماكان واضحاً للناس لدرجة سمعه الرواة، وكما هو معروف أنَّ للإمام الحسين× زوجات أُخريات في هذا الوقت، ولم أعثر على أيِّ بيت شعري للإمام بحق زوجة أخرى، وهذا يعني وجود تفرقة عند الإمام بين زوجاته !
وكما يقول ابن كثير: «قال الحسين في زوجته شعراً»([159]).
ولكنّي لم أعثر على أيِّ شعر للإمام الحسين× بحقِّ زوجته الرباب سوى هذه الأبيات المتناقضة.
لقد رافقت السيّدة الرباب الإمام الحسين× إلى كربلاء، وحُملت إلى الشام، ثمّ عادت إلى المدينة، فخطبها الأشراف، فقالت: ما كنت لأتخذ حموا بعد رسول الله|، وبقيت مدَّة سنة حتّى ماتت من الحزن، وقيل: إنها قامت على قبره سنة، ثمّ عادت إلى المدينة، ثمّ ماتت أسفاً عليه([160]).
ولقد رثت الإمام الحسين× قائلة:
|
إنَّ الذي كان نوراً يُستضاءُ به واللهِ لا أبتغي صهراً بصهركم صهركم حتى أُغيَّبَ بينَ الرَّمل والطين([161]). |
والرباب هذه هي التي طلبت رأس الإمام الحسين× من ابن زياد([162])، فلمّا رأته أخذته ووضعته في حجرها وقبَّلته وقالت:
|
و احسيناه ولا نسيتُ حسيناً |
كما أنَّ الإمام الحسين× أعطى كلَّ الرعاية والإهتمام لأولاده، وكان لكُل ولد من أولاد ه منزلة في قلبه. وقد اعتنى وأحبَّ السيّدة سكينة كثيراً على الرغم من عدم وجود نصٍّ تاريخي، ولكن يمكن استنتاجه عن طريق تصرفاته× معها أثناء واقعة الطف، وإنشاده× أبياتاً شعرية في حقِّها تدلُّ على علوِّ منزلتها في نفس والدها:
|
سيطولُ بعدي يا سكينة فاعلمي |
لقد عاشت السيّدة سكينة وسط عائلة طيبة، وُلدت في حجر الرباب بنت امرئ القيس، وعاشت مع عدد من الإخوان والأخوات، فأخوها الشقيق هو عبد الله بن الحسين×([165]).
أمّا الأخوة غير الأشقاء منهم:
1ـ علي الأكبر×([166]).
2ـ علي الأصغر×([167]).
3ـ جعفر بن الحسين×([168]).
4ـ أبو بكر بن الحسين×([169]).
5ـ عمر بن الحسين×([170]).
أمّا أخواتها فليس لديها أخت شقيقة، فالمصادر المتيسـرة
لا تزوّدنا
بمعلومات تفيدنا في ذلك، غير أنَّ بعض المصادر تشير إلى وجود أخت
لها من أبيها، هي فاطمة بنت الحسين÷([171])، وتذكر المصادر بأنَّها أكبر منها سنّاً،
ووالدة فاطمة هي السيّدة أمُّ إسحاق([172])، حيث كانت زوجة الإمام
الحسن×([173])، حتّى وفاته سنة 49هـ/669م([174]) وبعد ذلك تزوَّجت الإمام الحسين×، وهذا يعني أنَّها تزوَّجت الإمام الحسين×
سنة 50هـ/670م أو بعدها، وأنجبت السيّدة فاطمة بعد هذه الفترة، ومن ذلك فهي أصغر من
السيّدة سكينة.
كما ذُكِر أنَّ لها أختاً غير شقيقة اسمها رقية، ماتت في خربة الشام([175]).
وعلى أيِّ حال عاشت السيّدة سكينة‘ وسط إخوتها زين العابدين، وعلي الأكبر شهيد كربلاء، فكانت زهرة البنات العلويات، وشريكة اللبوات الحسينيات فاطمة ورقية في عصر النبوّة، وبلاغة الإمامة، وجمال الروح وعفاف النفس، وسموّ الأخلاق، فقضت ردحاً من الزمن معهم.
كانت السيّدة لها علاقة طيبة تجمعها مع إخوتها، ولا سيما الإمام زين العابدين والسيّدة فاطمة بنت الحسين÷، ولقد ذكرت بعض النصوص التاريخية هذه العلاقة، بينما لم تُذكر أيّ علاقة لها مع بقية إخوتها؛ والسبب وفاتهم واستشهادهم في وقت مبكر، والنصوص التاريخية تذكر علاقة السيّدة سكينة‘ والسيّدة فاطمة‘ عند مسير نساء الحسين× سبايا، وعلاقتها مع الإمام السجاد من بعد وفاة أبيها، وهذا طبيعي لعدم وجود ولي غيره.
أمّا علاقتهم منذ الصغر فلم أعثر على أيِّ نصٍّ يُوثِّق هذه العلاقة.
خامساً: ولادتها
أمّا ما يخصُّ تاريخ الولادة
فالمصادر المتوفِّرة لم تُحدِّد السنة التي وُلدت فيها؛ بَيدَ أنَّ الدراسة الحالية
واعتماداً على ما ذكرته المصادر التي ترجمتْ لها، من أنَّ تاريخ وفاتها في سنة 117هـ/735م([176])، واعتماداً على روايات الطّف يمكن أن نحسب عمرها أثناء واقعة الطّف ما بين 12
و14 سنة، ويمكن استشفاف ذلك لأنَّ أحد الناجين من الواقعة، وهو عقبة بن سمعان([177])
كان مولى سكينة؛ إذ يشير نصُّ أبي مخنف الأزدي
ـ الذي نقله الطبري ـ إلى أنَّ عقبة كان مولى سكينة؛ إذ كانت يومئذ في الطّف صغيرة([178]).
ومن هنا يظهر تاريخان لولادتها؛ إمّا سنة 42هـ، أو 47 هـ/662ـ667م، وعلى الرغم من صعوبة ترجيح احتمال سنة ولادتها ـ لعدم وجود المسوِّغات التي تؤيّدهاـ إلاّ أنَّه بالإمكان أيضاً الاعتماد على الرواية التي تذكر بأنَّ السيّدة سكينة أدركت سنَّ الزواج في حياة والدها؛ حيث ذُكر بأنَّ الحسن بن الحسن السبط جاء عمَّه الحسين× طالباً منه أن يزوِّجه إحدى ابنتيه: فاطمة، أو سكينة، فزوَّجه فاطمة([179]).
و على الرغم من عدم وجود تاريخ دقيق لولادة السيّدة سكينة‘ فقد رجّح أكثر الباحثين تاريخ ولادتها 47هـ/667م.
وسنقدِّم استعراضاً للدراسات الحديثة: يقول المقرّم: «ولم يتّضح لنا سنة ولادتها، ولا مقدار عمرها، وإن أمكننا القول بأنَّها قاربت السبعين بعد ملاحظة سنة وفاتها وكونها يوم الطّف بالغة مبلغ النساء، لا أقلّ من التقدير بالعشرة، وذكرنا ولادتها سنة 47 هـ/677م»([180]).
أمَّا بنت الشاطئ فقد قالت: «فالقول بوفاتها وهي في نحو السبعين من عمرها، يجعل مولدها حوالي عام 47 هـ/677م، بعد سبع سنين من مقتل جدِّها الإمام علي، وانتقال الخلافة إلى معاوية كبير البيت الأموي»([181]).
أمّا البلداوي فيقول: «كان عمر السيّدة في واقعة الطّف بالاستنتاج التقريبي أنَّها كانت بين 11ـ 14 عاماً؛ أي أنّ ولادتها سنتا 47 ـ 48هـ/667ـ 668م، ولم نجد خبراً قطعيّاً بهذا الخصوص»([182]).
سادساً: نشأتها
الطفولة لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان؛ لأنَّها المحطَّة التي ترسم مستقبله، لكن ليس هناك نصوص تاريخية كافية حول طفولة السيّدة سكينة، ففي رواية أنَّ السيّدة جاءت إلى أُمِّها الرباب وهي صغيرة تبكي، فقالت لها أمُّها: ما بكِ؟فقالت: مرَّت بي دُبَيرَة ([183])، فلسعتني بأُبيرَة، فأوجعتني قُطيرَة ([184]).
هذا كلام يدلُّ على بلاغتها وإتقانها للغة العربية منذ طفولتها، كما يدلُّ على تعلّق السيّدة سكينة بأمِّها، وهذا بديهي، يذكر القزويني أنّ البنت تستأنس بأُمِّها أكثر من استئناسها بأبيها، وتنسجم معها أكثر من غيرها، وتعتبر روابط المحبة بين الأمِّ والبنت من الأمور الفطرية التي لا تحتاج إلى دليل؛ فالأنوثة من أقوى الروابط بين الأمِّ وبنتها([185]).
أمّا أبو الفرج الأصفهاني فقد وصفها بكونها (مزّاحة)، حيث يقول: «كانت سكينة مزّاحة فلسعتها دَبْرَة فولولت، فقالت لها أُمُّها مالك يا سيدتي وجزعت؟فقالت: لسعتني دُبَيرة مثل الأُبَيرة فأوجعتني قُطيرَة»([186]).
فإن صحَّ كلامه فإنَّ هذا يعني أنَّ السيّدة كانت منذ طفولتها خفيفة الظلِّ، محبوبة، وكانت مصدر أنس لأمِّها وأبيها، ولكن يمكن لقائل أن يقول انّه لو كان هذا الكلام صحيحاً فلماذا سمَّتها أُمُّها سكينة أليس لهدوئها وسكينتها منذ صغرها؟!
أمّا الرواية الأخرى فقد رُوي أنَّ جعيد بن هذان([187]) قال: أتيت الحسين بن علي وعلى صدره سكينة، فقال لأهله: يا أخت كلب خذي ابنتك عنّي؛ فسألني قائلاً: أخبرني عن شباب العرب، فقلت: أصحاب جلاهقات([188]) ومجالس، قال: أخبرني عن الموالي، قلت: آكل ربا، أو حريص دنيا، فقال: إنّا لله وإنّا اليه راجعون... يا جعيد النّاس أربعة: مَن له خلق وليس له خلاق، ومنهم مَن له خلاق وليس له خلق، ومنهم مَن له خلق وخلاق وذلك أفضل النّاس، ومنهم من ليس له خلق وليس له خلاق وذلك شرُّ النّاس([189]).
والمهمُّ من هذه الرواية هو الشطر الأول منها، حيث يقول جعيد: كانت سكينة على صدر الحسين×، وهذا دليل على حبِّ الحسين× لطفلته، وأنَّه كان يقضي وقتاً معها؛ كما هو دليل على أنَّها مصدر أنس لأبيها، وأنَّها قضت مغمورة برعاية الوالدين.
وفي رواية أخرى رُويت عن سكينة‘: عاتب عمِّي الحسن بن علي÷ في أمّي، فقال أبي:
|
لَعمرُك إنَّني لأحبُّ داراً |
إذا كان تاريخ ولادتها يقع ما بين عامي 42هـ و47هـ/662ـ667م، وهذا يعني إذا وُلدت سنة 42 هـ/662م فإنَّ عمرها عند وفاة عمِّها الحسن× أقلّ من 8 سنوات؛ أمّا إذا أخذنا على تاريخ ولادة 47هـ/667م فيعني عمرها عند وفاة الإمام الحسن 3 سنوات، والنتيجة يكون عمرها يتراوح ما بين (3 ـ 8 سنوات)؛ فكانت منذ طفولتها نبهة. ولقد كانت حافظة للأبيات الشعرية؛ وبقيت في ذهنها إلى أن كبرت فروتها؛ (إن صحَّت الرواية).
لقد نشأت في أشرف بيوت بني هاشم، وترعرعت في رحاب الأسرة الهاشمية التي شكَّلت امتداداً ذاتيّاً للمتبنيات النبوية العظمى، التي أُنيطت بها الدعوة الإسلامية وحفظت الوحي، وحراسة الرسالة السمحاء.
سابعاً: تربيتها
التربية هي من أهمِّ الأمور للأطفال الذين يُراد تثقيفهم وتهذيبهم، أو تأديبهم على الوجه الصحيح؛ لأنَّها أساس كلِّ فضيلة، ودعامة كلِّ منقبة، وأوّل شيء يحتاج إليه في التربية هو اختيار المربي الكامل، العامل بالدروس التي يلقيها على مَن يُراد تربيته([191]).
تربَّت في بيت الحسين بن علي طاهرة شريفة، فقد فتحت عينها على صلوات تقام آناء الليل وأطراف النهار، وقرآنٍ يُتلى في الصباح والمساء، وفي آخر الليل حتّى مطلع الفجر، وقرآن الفجر إنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً([192]).
وكلُّ مَن يقرأ سيرة السيّدة ومواقفها أثناء معركة الطّف وما بعدها، يعرف البعد التربوي الذي نشأت عليه السيّدة، كما اعترفت كلُّ كتب التاريخ والسير بأخلاق السيّدة، وسوف أشير إليها لاحقاً.
وعلى الرغم من ظلامة هذه الفترة يقول الديوه جي: «تولَّت الرباب تربية ابنتها سكينة فأرضعتها الفصاحة والبلاغة منذ صغرها... وكثيراً ما كانت ترسلها إلى حلقات العلماء، ومجالس رواة الحديث فتأخذ عنهم، كما كانت تقصُّ عليها مآثر آبائها وأجدادها، فتذكِّرها بجدِّها الأعظم منقذ العالم من الشرك، وهاديه إلى طريق الحقِّ؛ وتسرد عليها أخبار جدِّها فتى الفتيان (حيدر)، وما كان عليه من البطولة والعلم والفقه في الدين، وكانت الفتاة ذكية الفؤاد، تصغي إلى هذه الأحاديث بكلِّ شوق، وتفتخر بمآثر أجدادها التي دوَّنتها بكلِّ فخر...»([193]).
كما توفّر في سبط الرسول جميع العناصر التربوية الفذّة، وقد أخذ بجوهرها قائد الأئمة وحامل رسالة الإسلام.
فمكوّنات التربية هي ثلاثة: الوراثة، والأسرة، والبيئة. لقد أكَّد علماء الوراثة على أنَّ الأبناء والأحفاد يرثون معظم صفات آبائهم وأجدادهم من صفات جسدية ونفسية، يقول العلايلي: الوراثة صنفان: وراثة تاريخية، ووراثة تأثّرية؛ ونعني بالأولى انتقال الصفات النفسية التي بالأجداد إلى المولود، وبالثانية انتقال أنواع الشعور التي تتأثّر بها الأم إلى الجنين، وهذا الصنف من الوراثة ثابت الأثر، وهو قانون طبيعي تخضع له جميع قوى الإنسان ومداركه المادية والعقلية([194]).
أمّا الأسرة فهي ضرورة فطرية تلبِّي حاجة نفسية عميقة في نفس الإنسان، وتنظِّمها اجتماعياً مدنياً للمساعدة في تربية الطفولة؛ لذلك عُني الإسلام بمكانة الأسرة واهتمَّ بها اهتماماً بالغاً([195]).
وأمَّا البيئة فهي عامل مهمٌّ من العوامل المهمّة التي يُعتمَد عليها في تشكيل شخصية الطفل واكتسابه العادات([196])، كلُّ هذه المكوّنات مهمّة في إنشاء شخصية الطفل، بل هي للبنات أهمّ؛ يقول البنا: يجب تطبيق المكوّنات التربوية للمرأة كما يرى الإسلام، من وجوب تهذيب خلق المرأة، وتربيتها على الفضائل والكمالات النفسية منذ بداية نشأتها، ويحثُّ الآباء والأولياء على هذا([197]).
ومن هذا المنطلّق فإنَّ السيّدة سكينة‘ نشأت في أسرة صالحة، فقد تربَّت في كنف والديها؛ إذ غذّتها أُمُّها بالعفّة والطهارة، وأبوها بآداب الإسلام وحكم القرآن، كانت نشأتها في تلك البيوت التي أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه، تلك البيوت التي أنجبت الأئمّة، أمثال الإمام زين العابدين والإمام الباقر÷.
ثامناً: رعاية السيّدة سكينة للستر والحجاب
قبل أن نذكر هذا الدور لابدّ من تعريف الحجاب لغة: فهو من الفعل الثلاثي حَجَب، والحجاب اسم ما حجبتَ به بين شيئين، وكلُّ شيء منع شيئاً فقد حجبه([198]).
أمّا الحجاب اصطلاحاً: فهو ستر المرأة بدنها حينما تتعامل مع الرجال([199]).
ومن هذا المنطلق سنوضِّح دور السيّدة سكينة في رعاية الحجاب.
لما وصل خبر مقتل الإمام الحسين× وأهل بيته وأنصاره إلى يزيد أرسل إلى ابن زياد كتاباً يأمره فيه بحمل رأس الإمام الحسين× ورؤوس من قُتِل معه، وأمره بأن يعجِّل بإرسال النساء والعيال، فسيَّرهم ابن زياد إلى الشام كما تُسيَّر سبايا الكفّار، فيتصفّح وجوههم أهل الأقطار([200])، ولمّا قرب الركب من دمشق طلبت أُمُّ كلثوم من شمر بأن يسلك بهم في درب قليل النظّارة، وأن يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل، إلاّ أنَّه جعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل؛ بغياً منه وكفراً([201]).
هكذا أرادت السيّدة أمُّ كلثوم أن تحافظ على النساء، واهتمّت بسترهنَّ؛ لأنَّ هذا جزء من القيم وأخلاق المرأة العلوية، التي سعت جاهدة في هذه الرحلة أن تراعي الستر والحجاب، وهذه من الأدوار المهمّة التي قامت بها المرأة الحسينية، وهو المحافظة على القيم والمُثُل والأخلاق الإسلامية التي نهض الإمام الحسين× من أجل ترسيخها والدفاع عنها؛ حيث تحتلُّ الأخلاق موقعاً مهمّاً في النظرية الإسلامية، وهي القاعدة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي؛ إذ إنَّ عصر الإمام الحسين× اهتزَّت فيه القيم الأخلاقية عند النّاس، بسبب الميل إلى الدّنيا، وطلب الشهوات والملذات، وكثرة الأموال، والتهالك على المناصب والسلطة، وغير ذلك من الأمور التي أدّت إلى ضعف الحالة الأخلاقية ([202]).
لقد قامت السيّدة سكينة‘ بدور في المحافظة على ستر النساء الهاشميات في الشام؛ وذلك لكي تحفظ قيم المرأة، فقد روي أنَّ سهل بن سعد الساعدي([203]) قال: خرجت إلى بيت المقدس حتّى توسّطت الشام، فإذا أنا بمدينة مطّردة الأنهار كثيرة الأشجار، قد علّقوا الستور والحجب والديباج، وهم فرحون مستبشرون، عندهم نساء يلعبنَ بالدفوف والطبول، فقلت في نفسي: لا نرى لأهل الشام عيداً لا نعرفه نحن؟! فرأيت قوماً يتحدّثون، فقلت: يا قوم لكم بالشام عيد لا نعرفه نحن؟! قالوا: يا شيخ نراك أعرابياً، فقلت: أنا سهل بن سعد قد رأيت محمداً |، قالوا: يا سهل ما أعجب السماء لا تمطر دماً والأرض لا تنخسف بأهلها؟! قلت: ولم ذلك؟ قالوا: هذا رأس الحسين× عترة محمد| يُهدى من أرض العراق، ثمّ يقول: فبينما أنا كذلك حتّى رأيت الرايات يتلو بعضها بعضاً، فإذا نحن بفارس بيده لواء، منزوع السِّنان، عليه رأس من أشبه النّاس وجهاً برسول الله|، ومن ورائه رأيت نسوة، فدنَوت من أولاهم فقلت: يا جارية من أنتِ؟ فقالت: أنا سكينة بنت الحسين، فقلت لها: ألك حاجة اليّ؟ أنا سهل بن سعد ممّن رأى جدَّك وسمعت حديثه، قالت: يا سعد قل لصاحب هذا الرأس أن يقدِّم الرأس أمامنا حتّى ينشغل النّاس بالنظر إليه، ولا ينظروا إلى حُرم رسول الله|، قال سهل: فدنوت من صاحب الرأس، فقلت له: هل لك أن تقضي حاجتي وتأخذ مني أربعمائة دينار؟ قال: ما هي؟ قلت: تَقَدَّم بالرأس أمام الحرم، ففعل ذلك، فدفعت إليه ما وعدته([204]).
وفي رواية أخرى دَنا سهل بن سعد الساعدي من سكينة بنت الحسين÷، وقال: ألكِ حاجة، فطلبت منه بأن يدفع لحامل الرأس شيئاً، فيبعده عن النساء؛ ليشغل النّاس بالنظر إليه، ففعل سهل([205]).
نستنتج من هذه الرواية أنَّ أهل الشام كانوا في حالة فرح، حيث نصبوا الديباج والطبول، واحتفلوا بمقتل الإمام الحسين×، كما تدلُّ على أنَّ أعداداً كبيرة من النّاس كانوا مستنكرين لهذا العمل، كما توضِّح أنَّ النساء دخلوا الشام، وكان أهلها يتفرّجون عليهم، وكانت السيّدة سكينة واقفة أوّل النساء، وكان كلُّ من ينظر إلى النساء ينظر إلى السيّدة سكينة أولاً لدرجة أنَّها لم تتحمّل هذا الموقف، فلمّا سألها سعد من أنتِ؟ أجابته بكلِّ فخر أنا سكينة بنت الحسين÷، وبالتالي لم يتردّد فأقبل يسأل السيّدة عن حاجتها، فطلبت منه ـ ماذكرناه آنفاً بأن يقول لصاحب الرأس أن يقدّم الرأس أمامهم ـ وهي واثقة من أنَّ الجيش الأموي قابل للرشوة وغير متماسك.
لم تتحمّل السيّدة أن ينظر النّاس إلى نساء الحسين×، وهذا التصرّف يدلُّ على حسن التربية والمدى الأخلاقي الذي تحمله السيّدة ورعايتها للستر، فهي لم تطلب من سهل الطعام ولا الماء ولا حتّى أن يكفَّ الجنود عن ضربهم، فقد حجّبت النساء عن أعين أهل الشام، وبالتالي أكملت دور السيّدة أمِّ كلثوم عندما طلبت من الشمر أن يقدِّم الرأس([206])، فهي تسير على خطى الهاشميات بكلِّ ثبات وإيمان.
ترى السيّدة سكينة‘ بالحجاب حرية المرأة، وبرفع الحجاب عنها إهانة لكرامة وشخصية المرأة، فهي تحمل رسالة وهدفاً لكلِّ مَن يريد أن يفهم قيمة الحجاب، فهو مسألة احترام لكرامة الإنسان وشرفه.
ليس هذا فقط، بل هناك موقف للسيّدة سكينة في مجلس يزيد يدلُّ على حشمة السيّدة وحسن تربيتها عند دخول النساء على يزيد، وكان يتطلّع فيهنَّ ويسأل عن كلِّ واحدة بعينها، وهن مربّطات بحبل طويل... أقبلت امرأة وكانت تستر وجهها بيدها، فقال: من هذه؟ قالوا: سكينة بنت الحسين÷، قال اللعين: أنت سكينة ؟ فسالت دموعها على خدِّها واختنقت بعبرتها، فسكت عنها حتّى كادت أن تطلع روحها من البكاء، فقال لها: وما يبكيك؟ قالت: كيف لا تبكي من ليس لها ستر تستر به وجهها عنك؟ فبكى يزيد الكافر وأهل مجلسه، ثمّ قال: لعن الله عبيد الله بن زياد ما أقسى قلبه على آل الرسول؟! ثمّ أقبل إليها وقال: ارجعي مع النسوة حتّى آمر بكنَّ أمري([207]).
هذا دليل واضح يحتاج إلى شرح مراعاة السيّدة سكينة للستر والحجاب، وهتك الحجاب بالنسبة للسيّدة سكينة كارثة لدرجة أنَّها كادت تطلع روحها من البكاء.
هذه الرواية تشير إلى أنَّ السيّدة كانت بعمر يسمح للآخرين أن يقولوا بأنَّها امرأة، كما تدلُّ على خداع يزيد وتبريره على فعلته بالبكاء، وإلقاء اللوم على عبيد الله؛ ظنّاً منه بأنَّ هذا التصرُّف سينجيه، فكان بكاؤه سبباً لغلبة الخوف علي نفسه من اقتراب أجله وزوال دولته.
تاسعاً: عبادتها وزهدها
لقد كانت السيّدة سكينة من النساء العابدات الفاضلات الزاهدات في الدّنيا وملذّاتها منذ صغرها، وخير دليل على كلامنا هذا أنَّ الإمام الحسين× قال في ابنته سكينة ـ عندما أتى الحسن المثنى بن الحسن إلى الحسين÷؛ يخطب إحدى ابنتيه فاطمة، أوسكينة ـ قال له أبو عبد الله×: أختار لك فاطمة؛ فهي أكثر شبهاً بأُمِّي فاطمة بنت رسول الله|، وفي العبادة كانت تقوم الليل كلَّه، وتصوم النهار، وفي الجمال تشبه الحور العين، وأمَّا سكينة فغالب عليها الإستغراق مع الله تعالى؛ فلا تصلح لرجل([208]).
هكذا عبّر الإمام الحسين× عن عبادة بناته واحدة تقوم الليل كلّه، والأخرى يغلب عليها الإستغراق مع الله تعالى، وعندما وصفها بالاستغراق يعني الشمول في العبادة بحيث لا يخرج عنها شيء([209])، وهذا دليل قاطع على عبادة السيّدة سكينة وزهدها لدرجة أنَّها لم تصلح لرجل، علماً بأنَّ السيّدة سكينة غير متزوجة.
يقول المقرّم: «هذه الكلمة الذهبية من سيد شباب أهل الجنّة× تفيدنا درساً بليغاً عن مكانة ابنته سكينة من الشريعة المقدّسة، وإنَّ اختها الطاهرة مهما حازت الثناء الغير متناهي لا تبلغ ثناءها، ولا تجاريها في الرهبانية، والتجرّد عن اللذات، والإنقطاع عن الدّنيا الفانية...»([210]).
واستمرّت السيّدة سكينة في عبادتها حتّى في الأوقات العصيبة التي مرّت بها، وقد ذكرت السيّدة منامها الذي رأته حيث قالت: يا يزيد رأيت البارحة رؤيا إن سمعتها مني قصصتها عليك، فقال يزيد: هاتي ما رأيتي، قالت: بينما أنا ساهرة وقد كللت من البكاء بعد أن صلّيت ودعوت الله تعالى بدعوات... ([211]).
وهذا دليل آخرعلى أنَّ السيّدة في ذلك الوقت كانت تحمد الله وتصلي، كما تعطي برهاناً حول شروط الرؤية الصحيحة، كذا كانت السيّدة سكينة تقوم بكلِّ العبادات التي أمر الله بها؛ كانت تحجُّ([212])، وكانت تتصدّق على الفقراء والمساكين، وكانت تعطي الإمام السجاد× عندما يريد الخروج إلى حجٍّ أو عمرة سُفرة([213])، تنفق عليها ألف درهم أو نحو ذلك، فترسلها إليه فإذا أظهر الجرَّة أمر بها فتُقسَّم على المساكين([214]).
وهذا دليل على أنّ السيّدة سكينة كانت تعيش مع أخيها الإمام زين العابدين×، وهو ولي الأمر عليها، وكانت تستعين به في توزيع الأموال على الفقراء؛ وذلك لحشمة السيّدة سكينة وعدم مخالطتها سكان المدينة.
كانت عالمة بالمسائل الفقهية، فقد رُوي أنَّ السيّدة سكينة حجّت ذات مرة، فرَمَت الجمرة، ورجل يناولها الحصى، تكبِّر مع كلِّ حصاة، وسقطت حصاة فرمت بخاتمها([215])، وهذه من السوابق الفقهية التي استدلَّ بها العلماء ما كان من فعل السيّدة سكينة، لجواز أن يكون فصُّ الخاتم حجراً، وبذلك ينتقض قياس أبي حنيفة ([216]).
ومن هذه الروايات أنَّ السيّدة سكينة‘ قانعة بالرزق القليل، محبة للعبادة كثيراً فهي منصرفة عن الدّنيا، مستهينة بالمال، ترمي بخاتمها الثمين دون تردّد؛ لتستكمل الشعائر الدينية، وهي المستغرقة في الله لا تطلع أحداً على عبادتها إياه، فلا يتبيّن انصرافها للعبادة إلاّ من خلال ردِّ أبيها لأحد خطّابها، فلها مناجاة بينها وبين الله تعالى([217]).
ولقد وصفها رجال التاريخ بأجمل العبارات لما تميّزت به من العفّة والعبادة والشجاعة، فكانت سيّدة نساء عصرها، وأحسنهنَّ أخلاقاً([218])، ولم يكن في زمانها أحسن منها([219])، وكانت من سيّدات النساء، ومن أهل الجود والفضل([220])، وكانت مشهورة بحُسن خلقها([221]).
هكذا كانت السيّدة سكينة، فإذا تأمّل المتأمّل إلى ما كانت عليه هذه الطاهرة من العبادة لله تعالى، والإنقطاع إليه لم يُشكَّ فيها أبداً، وإنَّها كانت من النساء اللواتي وقفنَ حركاتهن وسكناتهن وأنفسهن للباري تعالى، فحصلت على المنازل الرفيعة والدرجات العالية التي حكمت برفعتها منازل المرسلين، ودرجات الأوصياء.
عاشراً: وفاتها
وقد اتفقت أغلب المصادر على تاريخ وفاتها في سنة 117هـ/735م([222])، لكن اختلفوا في مكان دفنها، فمنهم مَن يذكر في المدينة، وكان على المدينة خالد بن عبد الله ابن الحارث بن الحكم فقال له: انتظرني حتّى أصلّي عليها، وخرج إلى البقيع، ولم يدخل حتّى الظهر وخشي أن تتغيّر فاشتروا لها كافوراً بثلاثين ديناراً، فلمّا دخل شيبة بن نصاح([223]) صلّى عليها([224])، وروى ذلك أيضاً أبو الفرج الأصفهاني لكن بمسمّيات مغايرة؛ إذ قال: «إنَّه لم يُصَلَّ على أحد بعد رسول الله بغير إمام إلاّ سكينة بنت الحسين÷، فإنَّها ماتت وعلى المدينة خالد بن عبد الملك([225]) فأرسلوا إليه فأنبأوه بالجنازة وذلك في أوّل النهار في حرٍّ شديدٍ، فأرسل إليهم لا تُحْدِثوا حدثاً حتّى أجيء فأُصلِّي عليها، فوُضِع النعش في موضع المصلّى على الجنائز، وجلسوا ينتظرونه حتّى جاء الظهر... فجاء العصر... صُلِّيت العشاء... ومكث النّاس جلوساً غلبهم النعاس، فأقبلوا يصلّون عليها جمعاً جمعاً، وينصرفون، فقال علي بن الحسين÷: من أعان بطيب رحمه الله، قال: وإنّما أراد خالد بن عبد الملك فيما يُظنُّ أن تنتن، فأُتى بالمجامر، فوُضِعت حول العرش...»([226]).
ترى الباحثة أنَّ السيّدة بقيت تعيش إلى جانب أخيها زين العابدين، كما أنَّها عاصرت شطراً من حياة الإمام الباقر×وهو الإمام المفترض الطاعة بعد أبيه، فهل يُعقَل أن يترك عمَّته يصلّي عليها والي المدينة ويتركها فترة من الزمن بغير تكفين ولا تغسيل؟!
أمّا بخصوص رواية أبي الفرج الأصفهاني فهي ضعيفة؛ وذلك لأنّ من المعروف أنّ وفاة الإمام السجاد سنة 94هـ/712م([227])، فكيف يحضر وفاة أخته وهو ميت قبلها؟!
ويرى آخرون أنَّ وفاتها في دمشق، معتمدين على قبر موجود في طبرية ([228]) منسوب إلى السيّدة سكينة، إلى جوار السيّدة أمِّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب([229]).
إلا أنَّ ياقوت الحموي يؤكّد أنَّها دُفنت في المدينة، وينفي قبرها في طبرية قائلاً: «... في ظاهر طبرية قبر، يرون أنَّه قبر السيّدة سكينة، والحقُّ أنَّ قبرها بالمدينة»([230]).
كما ينفي الأمين دفن السيّدة سكينة في دمشق، ويؤكِّد على أنّها في المدينة، فيقول: «... أمّا القبر المنسوب إليها بدمشق في مقبرة الباب الصغير فهو غير صحيح؛ لأجماع أهل التواريخ على أنَّها دُفنت بالمدينة، ويوجد على القبر المنسوب إليها بدمشق صندوق من الخشب كُتبت عليه آية الكرسي بخطٍّ كوفي... وأخبرني عبّاس القمّي ـ الخبير بقراءة الخطوط الكوفية بدمشق في رجب أو شعبان سنة 1356هـ ـ أنَّ الاسم المكتوب بآخر الكتابة التي على الصندوق سكينة بنت الملك...»([231]). ومن هنا فنستبعد الرواية التي تقول قبر السيّدة سكينة في الشام.
ويرى بعض أنَّها خارج مكّة في القبّة التي في الزاهر في طريق العمرة ([232])، كما يرى آخرون أنَّ وفاتها في مصر؛ معتمدين على زواجها من الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان([233])، حيث ذُكِر أنَّ أوّل من دخل مصر من ولد علي بن أبي طالب هي سكينة بنت الحسين÷([234]).
وهذه الرواية مستبعَدة؛ وذلك لعدم زواج السيّدة سكينة‘ من بعد ابن عمها، وماتت بكراً([235])، كما أنَّها ليست أوّل من دخل مصر من ولد علي بن أبي طالب فقد خرجت معها السيّدة زينب، والسيّدة فاطمة بنت الحسين^.
فقد روي عن الحسن بن الحسن، قال: لمّا خرجت عمتي زينب من المدينة خرج معها من نساء بني هاشم: فاطمة ابنة عمّي الحسين× وأختها سكينة ([236])، كما يؤكِّد الصفار أنّ الداخلة إلى مصر مع السيّدة زينب‘ هي سكينة بنت علي بن الحسين÷ وليست السيّدة سكينة ابنة الحسين÷([237]).
هكذا أكملت السيّدة سكينة‘ امتحانها بنجاح، وقطعت شوط الحياة الصعب بإخلاص ويقين، وطوت عقوداً من سنين الدّنيا في الجهاد.
ومن إشراقات عظمة السيّدة أن تتنافس البقاع والبلدان على ادّعاء شرف احتضان مرقدها ومثواها، ففي أكثر من بلد تُقام الأضرحة، وتشمخ القباب والمنائر باسم السيّدة سكينة؛ إذ اختلف المؤرخون في مكان وفاتها ومحلِّ قبرها، وشاء الله تعالى أن يكون ذلك سبباً لإظهار عظمتها وإبراز شأنها ومجدها.
وسنتحدث في سطور قليلة عن أبرز المقامات المشيَّدَة باسم السيّدة سكينة.
حادي عاشر: مشهدها
بالنسبة إلى مشهدها في الشام موجود في مقبرة الباب الصغير، إلى جوار السيّدة أمِّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب، شُيِّدت هذه المقامات بمساعي السيد سليم أفندي ابن السيد حسين أفندي مرتضى، قائم مقام أهل البيت سنة 1330هـ/1937م([238]).
وفي هذا المسجد منارة حديثة تقع بين القبَّتين اللتين فوق ضريحي السيدتين سكينة وأمِّ كلثوم، والقبّتان جُدِّدتا سنة 1303هـ/1885م، كما هو مؤرَّخ على الباب، وللقبَّة الشمالية باب شمالي إلى المقبرة، وشبّاكان في كلِّ جهة من الجهات الثلاث الأخرى، وللقبّة الجنوبية شبّاكان إلى الجنوب، واثنان إلى الشرق، وفي الجنوب باب يؤدّي إلى غرفة يقيم فيها قيِّم المسجد، وفي أرض القبّة الجنوبية عشر درجات، يُنزَل فيها إلى الطابق التحتاني، وفيه ممرٌّ، في جانبه غرفتان: جنوبية فيها ضريح السيّدة أمِّ كلثوم وتابوتها من خشب حديث الصنع، وفي الغرفة الشمالية ضريح السيّدة سكينة ([239])، وعلى التابوت نقوش وزخارف وكتابات بالخطِّ الكوفي، مشجَّر جميل، مصنوع من الخشب المحلّى بالزخارف المحفورة والكتابات، ويرجع تاريخ الصنع إلى العصر الفاطمي([240]).
طول التابوت ثلاثة أمتار، وعرضه متر ونصف، وارتفاعه متر([241]).
ويُسمَّى مسجد السيّدة سكينة ومسجد الخضر أيضاً([242])؛ أمّا بخصوص مشهدها في مصر فيقع في حيِّ الخليفة بالقاهرة بالشارع المسمَّى باسمها([243])، وفي وسط هذا الشارع مشهد السيّدة سكينة‘ يُقصد بالزيارة، وتُقرأ فيه الأدعية كلَّ يوم خميس ويُقام فيه المولد النبوي كلَّ عام([244])، وأما عن مشهدها ومسجدها، فقد عمَّرهما الأمير عبد الأمير عبد الرحمن كتخدا عام 1173هـ/1759م، في عهد علي باشا مبارك، ولقد وُصِف الضريح بأنَّه مجلَّل بالبهاء والنور، وعليه تابوت من الخشب وأوقافه تحت نظر الديوان، وكان الضريح قبل عهد عبّاس باشا الأول منخفضاً عن سطح أرض المسجد فرُفع الضريح إلى ما يقرب من مستوى سطح المسجد، ووُضعت عليه مقصورة من النحاس، وقد جُدِّدت القبّة والمسجد في عهد عبّاس حلمي عام 1232هـ/1816م، ومنذ ذلك التاريخ هو في صورته الحالية ([245]).
والمسجد موجود حالياً، يرجع إلى عهد عبد الرحمن كتخدا سنة 1173هـ/ 1759م ثمّ جدَّدته بعد ذلك وزارة الأوقاف في القرن الثالث عشر الهجري، وعلى الباب المقصورة النحاسية توجد لوحة تذكارية مؤرَّخة سنة 1216هـ([246]).
ويمكن القول بأنَّ مشهد السيّدة سكينة كان يحظى باهتمام الخلفاء الفاطميين طيلة مدّة حكمهم، ويُعدُّ هذا المشهد من المزارات ذات القداسة العالية لدى المصريين.
إضافة إلى أنَّه كان مأوى للمعوزين والمحتاجين الذين تكفَّلت الخلافة الفاطمية بتوفير المؤن لهم ولمن لا مأوى له، فضلاً عن اهتمامهم بالمزارات وتطويرها، والعمل على صيانتها من جميع الجوانب.
الفصل الثاني
مواقف وأدوار السيّدة سكينة في النهضة الحسينية
أولاً: مواقف السيّدة سكينة‘ قبل معركة الطف
لقد تساءل الكثير عن مسألة اصطحاب الحسين× النساء، ومن ضمنهنَّ السيّدة سكينة، ولكن لم تذكر المصادر التاريخية سبب ذلك الإصطحاب([247])، إلاّ أن بعضها أكَّدت على إصرار الإمام الحسين× على حملها معهُ، نستدلُّ على ذلك من خلال كلام عبد الله بن عبّاس عندما قال للحسين×: «... إن كنت لا محالة سائراً، فلا تخرج النساء والصبيان، فإنّي لا آمن أن تُقتل كما قُتل ابن عفّان وصبيته ينظرون إليه، فقال الحسين×: ياعَمّ ما أرى إلاّ الخروج بالأهل والولد»([248]).
ولقد روي أنّ الإمام الحسين× رأى النبي| في المنام وذلك عندما أراد الذهاب إلى العراق، فارتحل إلى محمّد بن الحنفية، فسأله ابن الحنفية: ما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ قال×: قال لي|: إنَّ الله قد شاء أن يراهنَّ سبايا([249]).
وفي رواية أخرى: أنَّ الله قد شاء أن يراهنَّ سبايا، مهتّكات، يُسقنَ في أسر الذلِّ، وهنَّ لا يفارقنني ما دمت حيّاً([250]).
ومن هنا تحمل مسألة اصطحاب الحسين× للنساء عدّة احتمالات وآراء، نستعرضها كما يلي:
يرى القرشي: «لقد صحب معهُ عياله ـ وهو يعلم ما سيجري عليها من الأسر والسبي ـ لأنَّ بها تُستكمَل رسالته، وتؤدّي فعاليتها في القضاء على العرش الأموي، وإعادة الحياة الإسلامية إلى واقعها المضيء»([251]).
وهذا يعني رضا الإمام الحسين× بالقضاء والقدر، كما يدلُّ على أنَّ هناك أمراً وتكليفاً شرعياً؛ كما يُستدلُّ عليه من كلمة شاء الله، ويدلُّ هذا على أنَّها المشيئة التشريعية التي يتعلَّق بها الأمر، فالله تعالى يريد أن يرى الحسين× المدافع والمحامي عن الدين([252]).
كما يرى العاملي أنَّ اصطحاب الإمام الحسين× للنساء امتحان لهنَّ كما امتُحِن الإمام الحسين×؛ فيقول: لقد حمل الحسين× نساءهُ معهُ ليواجهن المحن والبلايا والمصائب والرزايا، لأنَّ الله سبحانه شاء أن يراهنَّ سبايا يُنقلْنَ من بلد إلى بلد، يتصفّح وجوههنَّ القريب والبعيد في يد الأعداء الذين لا يتورّعون عن ارتكاب أبشع الجرائم الموبقة، حتّى قُتِل أوصياء الأنبياء وذُبِح الأطفال وسُبيت بنات الوحي([253]).
اما الحسني فيقول: لقد كان لسبي النساء والأطفال والطواف بهنَّ من بلد إلى بلد أثر من أسوأ الآثار على الأمويين ودولتهم، وكان الجزء المتمِّم للغاية التي أرادها الحسين× من نهضته، فلقد أثار الأحزان والأشجان في نفوس المسلمين، وكشف أسرار الأمويين وواقعهم السيئ، وأظهر قبائحهم ومخازيهم للعالم والجاهل. وفي الوقت ذاته كان سبيهم من جملة الوسائل لنشر الدعوة إلى العلويين، ومبدأ التشيع لأهل البيت، ولعن من شايع وتابع على قتل الحسين×([254]).
وترى الباحثة: أنَّ الإمام الحسين× لم يأخذ معه نساء العامّة، وإنّما أخذ معه نساء واعيات مؤمنات بثورته، وهُن أيضاً مبلِّغات يمتلكن كلَّ أدوات التبليغ السليم ليعرِّفنَ النّاس بالقضية والثورة وأهدافها وأسبابها، وليكشفن النِّقاب عن الوجه الأموي، وليكُنَّ سبباً لهزِّ الوضع وتحريكه، وضخِّ القيم الإسلامية، وتخليد النهضة الحسينية في الوجدان الشعبي على مدى القرون.
كما أنَّ في مسألة اصطحاب الإمام الحسين× للنساء تُطرح عدّة أسئلة: فلو لم يحمل معه نساءً وأبدلهن بعدد إضافي من الرجال، لقُتل الرجال بأكملهم، ولم يكن للثورة صدى ولم يتّضح لهاأيُّ هدف، فمن هنا يتّضح لنا الهدف الذي حُملت من أجله النساء، وهولإبقاء نار الثورة الحسينية مشتعلة.
أمّا لو لم يأخذ النساء معهُ لَكان حالها حال الكثير من النساء اللواتي جاءهنَّ خبر استشهاد أهل بيتهنَّ، فيكون دورهنَّ البكاء والحداد في رقعة معينة فقط (المدينة المنوّرة)، ولمدّة محدودة، بحيث يجهل النّاس أسباب خروج الإمام الحسين×، وتنتهي الثورة.
كما لو بقيت النساء في المدينة ستعمل السلطات الأموية الضغط على الطرفين، فستُرغِم الإمام الحسين× على الإذعان للسلطة الأموية، ولربما ستضغط على النساء هناك، كما فُعل مع زوجة المختار عمرة بنت النعمان التي قتلها مصعب بن الزبير بعد الضغط عليها في نصوص نبوءة المختار([255]).
كما لو لم يأخذهنَّ معه لقُتِل الإمام الحسين× وأهل بيته في أيِّ بقعة من بقاع الأرض وقبل وصول الإمام الحسين× إلى كربلاء، وبالتالي لم يعلم حتّى أهل الكوفة بقدومه، ولربما سيلومون الحسين× كما فعلوا مع الإمام الحسن× من قبل.
لذلك كان الإمام الحسين× يفكّر بالدور الكبير الذي تحقِّقهُ النساء العلويات، كما استجابت العلويات للخروج معه؛ لأنَّ النساء كُنَّ على علم بأنَّ الحسين× سيقوم بنهضة إصلاحية كبيرة في أُمَّة جدّه|، وقد اتّضح لهنَّ هذا عندما قال: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمَّة جدي محمد|، أريد أن آمر بالمعروف وأنهي عن المنكر...»([256]).
ومن هنا كانت السيّدة سكينة‘ شاهدة للنهضة الحسينية، كما هي شاهدة على الكثير من مواقف الأسى وظلم بني أميّة، فكانت على قدر المسؤولية التي حملها الحسين×، وإلا فإنَّ دماء الشهداء كانت ستذهب سدىً من دون دور السيّدة سكينة وباقي النساء.
ومن هنا بدأت المرحلة التاريخية لحياة السيّدة سكينة؛ إذ ساندت الإمام الحسين× بقراره في الرحيل إلى درب الشهادة، وهذا يدلُّ على التفكير والوعي السياسي العميق، وذلك لملاحظتها الموقف السياسي المتأزِّم بين الإمام الحسين× ويزيد، ومدى خطورة هذه المسألة على الأمَّة الإسلامية.
كما أنَّ هناك مسألة مهمّة وهي أنَّ السيّدة سكينة لم تكن في أعداد الأطفال الذين حملهم الحسين×، وإنّما كانت بالغة، وكانت تدرك كلَّ تلك الأهداف، ومن هنا فواقعة الطّف كانت في حاجة إلى السيّدة سكينة؛ حيث أكملت الدور الذي قامت به السيّدة زينب‘([257])، وهذا ما سأوضّحه لاحقاً.
السيّدة سكينة‘ ومعركة الطف
قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع لابدّ من الإشارة إلى أنَّ الكثير من الحقائق التاريخية حُجِبت نتيجة الضغط من السلطات الأموية، ولاسيما أحداث ما بعد واقعة الطف، كما أنَّ مَن يقرأ ترجمة السيّدة سكينة يقرأ سطوراً قليلة عن حياتها، دون أن يجد أيَّ معلومات كافية حولها، كما لم تذكر المصادر شيئاً عن دورها في واقعة الطّف وكأنَّها غير موجودة أصلاً([258]).
والهدف من هذا شغل النّاس عن الدور الذي قامت به هذه السيّدة الجليلة، لذلك فإنَّ أغلب المواقف حصلت عليها بصعوبة ومن بين طيّات الكتب، وأغلبها جاءت نقلاً عن المصادر الحديثة.
لقد كانت السيّدة سكينة جزءاً من الركب الحسيني الذي خرج من مكّة إلى الكوفة في أواخر سنة 60هـ/679م، ولم تكن السيّدة سكينة قد شاهدت هذا المكان من قبل، فكانت هذه الرحلة الأولى لها، إذ كانت في مدينة جدِّها رسول الله|، وهي المكان الذي وُلدت فيه ونشأت طفولتها بأمان، وقد رَوت السيّدة سكينة‘ ذلك بقولها: كان خروجنا من المدينة أشقَّ شيء([259]).
يتّضح من كلامها أنَّه أشقُّ على الركب الحسيني بأكمله، وليس على السيّدة وحدها، ولربما لإدراك النساء وكلِّ مَن كان في الركب الحسيني بأنَّ الحسين× مقتول لا محالة ، ولربما لبعد المسافة التي قطعتها كانت هذه الرحلة شديدة على قلب السيّدة سكينة، وفي نفس الوقت قد شاهدت أباها عندما تلقّى خبر استشهاد مسلم بن عقيل وسمعته يردد:
|
لَئِنْ كَانَتِ الدّنيا تُعَدُّ نَفِيسَة
|
وفي اليوم الثاني من محرم نزل الإمام الحسين× في كربلاء، ونُصِبت الخيام([261])، واستعدَّ الإمام الحسين× لهجوم الجيوش الأموية، وفي هذا اليوم أيضا وافاه عمر بن سعد في أربعة آلاف فارس([262])، فدخل الطرفان في مفاوضات، ولقاءات ، ومكاتبات، حتّى اليوم التاسع من محرم.
وقد رُوي عن السيّدة سكينة‘ في ليلة العاشر أنّها قالت: «كنت جالسة في ليلة مقمرة وسط الخيمة، وإذا أنا أسمع من خلفها بكاء وعويلاً، فخشيت أن يفقه بي النساء، فخرجت أعثر بأذيالي، وإذا بأبي× جالس وحوله أصحابه وهو يبكي، وسمعته يقول لهم: اعلموا أنّكم خرجتم معي لعلمكم أنّي أقدم على قوم بايعوني بألسنتهم وقلوبهم، وقد انعكس الأمر؛ لأنّهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، والآن ليس لهم مقصد إلاّ قتلي وقتل مَن يجاهد بين يديّ، وسبي حريمي بعد سلبهم، وأخشى أن تكونوا ما تعلمون وتستحيون، والخداع عندنا أهل البيت محرَّم، فمَن كَرِه منكم ذلك فلينصرف، فالليل ستير، والسبيل غير خطير، والوقت ليس بهجيرٍ، ومَن وآسانا بنفسه كان معنا غداً في الجنان، نجيّاً من غضب الرحمن، وقد قال جدي محمد|: ولدي الحسين يُقتَل بأرض كربلاء غريباً وحيداً عطشاناً فريداً، فمَن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم، ولو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة»([263]).
ثمّ قالت سكينة: فوالله ما أتمَّ كلامه إلاّ وتفرّق القوم من عشرة وعشرين فلم يبقَ معه إلاّ واحد وسبعون رجلاً، فنظرت إلى أبي منكِّساً رأسه فخنقتني العبرة، فخشيت أن يسمعني ورفعت طرفي إلى السماء، وقلت: اللهمَّ إنَّهم خذلونا، فاخذلهم ولا تجعل لهم دعاءً مسموعاً، وسلِّط عليهم الفقر، ولا ترزقهم شفاعة جدي يوم القيامة، ورجعت ودموعي تجري على خدي، فرأتني عمتي أمُّ كلثوم([264]) فقالت : ما دهاك يا بنتاه! فأخبرتها الخبر، فصاحت: واجدَّاه! واعلياه! واحسناه! واحسيناه! واقلة ناصراه! أين الخلاص من الأعداء؟ ليتهم يقنعون بالفداء! تركت جوار جدّك، وسلكت بنا بعد المدى! فعلا منها البكاء والنحيب، فسمع أبي ذلك، فأتى إلينا يعثر في أذياله ودموعه تجري، وقال: ما هذا البكاء؟فقالت: يا أخي! رُدَّنا إلى حرم جدِّنا.
فقال×: يا أختاه ليس إلى ذلك سبيل.
قالت: أجل، ذكِّرْهم محلَّ جدك وأبيك وأُمك وأخيك.
قال: ذكَّرتهم فلم يذكروا، ووعظتهم فلم يتعظوا، ولم يسمعوا قولي، فما لهم غير قتلي سبيل، ولابدّ أن تروني على الثرى جديلاً، ولكن أُوصيكنَّ بتقوى الله ربِّ البرية، والصبر على البلية، وكظم نزول الرزية، وبهذا وعد جدُّكم، ولا خلف لما أوعد، ودّعتكم الله الفرد الصمد، ثمّ تباكيا ساعة، والإمام× يقول: (وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)([265])([266]).
حملت الرواية الكثير من تفاصيل ليلة العاشر، فروت حالتها عندما رأت الإمام الحسين× منكِّساً رأسه وتفرُّق أصحابه عنه، فقالت: خنقتني العبرة...
إنَّ هذه الرواية تحمل الكثير من المعاني، فمن بداية الرواية تقول: خشيت أن يفقه بي النساء، فهذا دليل على أنَّ السيّدة سكينة لم ترغب في خلق حالة من الذعر والقلق على الهاشميات، وذهبت بمفردها، وهي واعية لما سيقوله الإمام الحسين×، فروت قول الإمام الحسين× الذي يحمل تفسير قدومه، فكان يلقي الحجّة على القوم، وأوضح الإمام الحسين× حال أهل الكوفة بقوله: قوم بايعوني بألسنتهم وقلوبهم، وقد انعكس الأمر؛ لأنّهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله([267]).
كما بيَّن مقاصد الجيش الأموي بقوله: «ليس لهم مقصد إلاّ قتلي ومَن يجاهد بين يدي، وسبي حريمي بعد سلبهم»([268])، وهذا دليل على علم الإمام الحسين× بالحالة المأساوية التي ستمرُّ بها النساء.
كما أنَّ الإمام الحسين× لم يجبر أصحابه على القتال معه؛ إذ قال: «فمن كره منكم فلينصرف»([269])، فوضّحت هذه الرواية حال الإمام الحسين×، وكيف ألقى الحجّة على أصحابه، كما وضّحت عدد أصحاب الإمام الحسين× الذين قاتلوا معه، وعددهم واحد وسبعون رجلاً، كما تدلّ على أنَّ السيّدة سكينة كانت صبورة وتقبّلت هذه الحادثة بصبر وإيمان، وكتمت حزنها وفوّضت أمرها إلى الله تعالى، فرفعت يدها بالدعاء ودعت على هؤلاء الذين تركوا والدها حزيناً بالخذلان، وعدم استجابة الدعاء ، والفقر، وعدم شفاعة جدّها لهم يوم القيامة، فرجعت وهي تكتم حزنها؛ لأنَّها تعلم بأنّ دموعها ستزيد هَمَّ الإمام الحسين×، فأخبرت عمّتها بكلِّ هدوء، ولكنَّ هذا الخبر أحزن السيّدة أُمَّ كلثوم ولم تستطع أن تخفي حزنها، كما فعلت السيّدة سكينة فعلا صوتها بالبكاء، فقال لهنَّ لابدّ أن تروني على الثرى جديلاً. ثمّ أخذ يوصي السيّدة أُمَّ كلثوم والسيّدة سكينة، وكانت وصيته تقوى الله والصبر والكظم على نزول الرزية لكي تؤدّي كلُّ واحدة دورها، الذي كان يهدف إليه الإمام الحسين×، فكانت هذه وصية الإمام الحسين× الأولى لعزيزته سكينة.
|
|
ثانياً: مواقف السيّدة سكينة في واقعة الطف
1ـ موقف السيّدة سكينة من استشهاد علي الأكبر×
لم تصوّر المصادر الكثير من مواقف الهاشميات، بل ركّزت على أحداث المعركة وعلى الدور البطولي للسيّدة زينب‘، أمّا السيّدة سكينة‘ فقد روت حالة الإمام الحسين× عندما استُشهد شبيه النبي|، فقالت: لمّا سمع أبي صوت ولده وهو يقول: «يا أبتاه عليك منّي السلام»([270]) رأيته قد أشرف على الموت وعيناه تدوران كالمحتار وجعل ينظر إلى أطراف الخيمة، وكادت روحه أن تطلع من جسده، وصاح وسط الخيمة وَلَدي، قتل الله قوماً قتلوكم([271]).
لقد صوّرت لنا السيّدة سكينة حالة مأساوية، إذ كانت تسمع صوت الشهيد ينادي أباه، وترى بعينها حال الحسين×.
أمّا حال السيّدة سكينة وموقفها عندما رأت أخاها فقد صوّره لنا النقدي قائلاً: «لمّا رأت نعش أخيها علي الأكبر وقعت عليه وغشى عليها»([272])، هكذا استقبلت السيّدة سكينة استشهاد علي الأكبر، ولم تذكر المصادر الأخرى شيئاً عن ردّة فعل السيّدة، بينما ذكروا موقف السيّدة زينب‘ لمّا جاءها خبر استشهاد علي الأكبر، حيث خرجت تنادي: «يا حبيباه وابن اخاه، جاءت حتّى انكبّت عليه...»([273]).
كما تدلُّ هذه الرواية على أنَّ السيّدة سكينة كانت شاهدة على كلِّ الأحداث، وهي ثاني من علم باستشهاد علي الأكبر من بعد الحسين×.
2ـ موقف السيّدة سكينة من استشهاد أبي الفضل العبّاس×
لقد ذُكر أنَّ أبا الفضل العبّاس× لما وقع على الأرض صريعا جاءَهُ الإمام الحسين×، فانحنى عليه ليحمله، ففتح العبّاس عينيه، فرأى أخاه الحسين× يريد أن يحمله، فقال له: إلى أين تريد بي يا أخي؟ فقال له إلى الخيمة، فقال: «أخي بحقّ جدّك رسول الله| عليك أن لا تحملني، دعني في مكاني هذا، فقال الحسين× لماذا؟ قال: إنّي مستح من ابنتك سكينة، وقد وعدتها بالماء ولم آتها به...»(2).
ويضيف المقرّم: «لمّا رجع الحسين× رأته سكينة مقبلاً، أخذت بعنان جواده وقالت: أين عمّي العبّاس، أراه أبطأ بالماء؟ فقال لها: إنّ عمّك العبّاس قُتل»([274]).
فسمعت زينب‘ فنادت: «واأخاه، واعبّاساه، واضيعتنا بعدك، وبكت النسوة وبكى الحسين× معهنَّ، ونادى واضيعتنا بعدك أبا الفضل، ونادى الآن انكسرظهري، وقلّت حيلتي»([275]).
ترى الباحثة ما ذُكر من أنّ الإمام الحسين× طلب من العبّاس أن يجلب الماء للأطفال([276]) معناه: أنّ الأطفال كانوا على علم بأنَّ العبّاس سيقدم بالماء، كما يتّضح لنا أنّ الإمام الحسين× هو الذي طلب منه أن يجلب الماء، وليس السيّدة سكينة، فلربما بعدما طلب الإمام الحسين× ذلك وعد العبّاس السيّدة سكينة بأنّه سيجلبه لهم، وهي واثقة من شجاعة العبّاس، فلذلك لما قُتل العبّاس خشى أن يبقى فيه رمق من الحياة وتراه السيّدة سكينة، وهي على أمل أن يجلب لها الماء لذلك رفض أن ينقله إلى الخيمة.
ولربما هناك علاقة وطيدة بين العبّاس وابنة أخيه، لذلك وعدها بالماء... واستحىا منها دون باقي النساء والأطفال.
كما تحملني الرواية إلى الإعتقاد بأنّ السيّدة سكينة كانت الأشدّ عطشاً من بين النساء والأطفال، ممّا جعل العبّاس يوعدها بالماء، ثمّ يستحي أن يراها، وهذا ما سنوضّحه في فقرة عطش السيّدة سكينة.
3ـ موقف السيّدة سكينة من أزمة العطش
لقد ذكرت المصادر أنّ عمر بن سعد أمر ابن الحجّاج أن يسير في خمسمائة
راكب؛ ليَحُولوا بين الحسين× وأصحابه وبين الماء([277])، وذلك قبل قتله بثلاثة أيام، فمكث أصحاب الحسين× عطاشى([278]).
لقد عانى الإمام الحسين× وأصحابه من العطش كما عانى أهل بيته، فكانت أزمة العطش مفزعة للكبار والصغار، وكان الملاذ لجميع أفراد العائلة ومعقد آمالهم زينب؛ لعلّها تدخر شيئاً من الماء، فكان بعض العائلة يأملون أن يجدوا عندها الماء جرياً على عادتها، فقد روت السيّدة سكينة: «عَزَّ ماؤنا ليلة التاسع من محرّم حتّى كضنا العطش، وقد نفد الماء كلُّه، وخلت الأواني، وجفّت القِرَب التي فيها الماء حتّى يبست من شدّة الحرِّ، فلمّا أمسى المساء عطشت أنا وبعض فتياتنا، فقمت إلى عمتي زينب أخبرها بعطشنا لعلّها ادّخرت لنا الماء، فوجدتها وفي حجرها أخي الرضيع، وهي تارة تقوم وتارة تقعد، وهو يضطرب اضطراب السمكة في الماء ويصرخ وهي تقول له: صبراً صبراً يا ابن أخي، وأنّى لك الصبر وأنت على هذه الحالة، يعزُّ على عمتك أن تسمعك ولا تنفعك، فلمّا سمعت انتحبت باكية ، فقالت: ما يبكيك؟ فقلت لها: حال أخي الرضيع، ولم أعلمها عطشي؛ خشية أن يزيد همُّها ووجدها، ثمّ قلت لها: يا عمتاه، لو أرسلت إلى بعض عيالات الأنصار فلربما يكون عندهم ماء، فقامت وأخذت الطفل بيدها ومرّت بخيم عمومتي، فلم نجد عندهم ماءً، فرجعت وتبعها بعض الأطفال رجاء أن تسقيهم ماء، ثمّ جلست في خيمة أولاد عمي الحسين×، وأرسلت إلى خيم الأصحاب لعلّ عندهم ماء، فلم نجد، فلما آيست رجعتْ إلى خيمتها ومعها ما يقارب عشرين صبياً وصبية، وهم يطلبون منها الماء، وينادون العطش العطش»([279]).
لقد روت لنا السيّدة سكينة هذه الرواية والتي صوّرت فيها العطش داخل المخيم، فقد صوّرت عطش الطفل الرضيع قائلة «يضطرب اضطراب السمكة في الماء»([280])، اذاً هذه أبشع وأقسى صورة، ولا يستطيع أحد أن يرى هذا المنظر المؤلم، حرمان رضيع من الماء لدرجة شارف على الموت من شدّة العطش.
لقد أحزن سكينة هذا الموقف وبكت، محاولة إخفاء حزنها عن السيّدة زينب، لكن مثل هذا الأمر لا يخفى على السيّدة زينب، كما صوّرت لنا حال الأطفال المحزن وهم يقفون على باب خيمة زينب ينادون العطش العطش، ولقد أعطتنا السيّدة سكينة إحصائية قريبة حول عدد الأطفال في ركب الحسين× بنحو عشرين صبياً وصبية.
ليس هذا فقط، بل روت السيّدة سكينة أنّها كانت عطشانة في اليوم التاسع، ويعني أنّها في اليوم العاشرأشدُّ عطشاً وألماً، وهذا ما صوّرته لنا السيّدة اُّم كلثوم في قصيدتها التي ألقتها حين توجّهت إلى المدينة ([281])، جعلت تبكي وتقول:
|
مَدينةَ جدِّنا لا تقبلينا |
إلى قولها:
|
سكينة تشتكي من حرِّ وجد |
فلم تصوّر أُمُّ كلثوم أحداً بهذا التصوير غير السيّدة سكينة. فربّما كانت السيّدة سكينة أكثر عطشاً من بين بنات الحسين×، ممّا جعل السيّدة أمّ كلثوم تذكرها في قصيدتها.
4ـ موقف السيّدة سكينة من استشهاد الطفل الرضيع([283])
استقبلت السيّدة سكينة أحداث واقعة الطّف واحدة بعد الأخرى، فقد روى عن حميد بن مسلم قال: كنت في عسكر ابن زياد فنظرت إلى الطفل الذي قُتل على يد الحسين×، وإذا قد خرجت من الخيمة امرأة قد كُسِفت الشمس بمحيّاها، وهي تعثر في أذيالها، تقع تارة وتقوم أخرى، وهي تنادي: واولداه واقتيلاه وامهجة قلباه، فبكت لسجعها بنو أميّة، حتّى أتت إلى الطفل الذبيح، وسقطت عليه تندبه طويلاً، خرجت خلفها بنات كاللؤلؤ المنثور، والحسين× يعظ القوم، فقلت لمن حولي: مَن ذا؟ فقالوا: أمُّ كلثوم وبنات الإمام الحسين× فاطمة الصغرى وسكينة ورقية ([284]).
هكذا شاركت السيّدة سكينة بقية الهاشميات فاجعة شقيقها الرضيع، خرجت خارج الخيمة فرأت بأمِّ عينها كيف ذبحوا شقيقها بغير ذنب.
5ـ موقف السيّدة سكينة من وداع الحسين
تنقل بعض المصادر أنَّ السيّدة سكينة‘، قالت لإحدى أخواتها ـ ويحتمل أن تكون هي السيّدة رقية ـ يوم عاشوراء ما نصّه: «هلمّي نأخذ برداء والدي ونحول بينه وبين الذهاب إلى الميدان»، وعندما سمع سيد الشهداء× صوتهنَّ بكى كثيراً، وإذا بالسيّدة رقية تناديه قائلة: «ابتاه! لن أحول دون ذهابك إلى الميدان، ولكن قف لي هنيهة لأراك وأتزوّد منك...»([285]).
يتّضح لنا أنَّ السيّدة سكينة علمت بأنَّ ساعة الإمام الحسين× قد قاربت، فحاولت أن تمنعه من المسير إلى القتال؛ لما تدركه من كثرة أعداد الجيش والحسين× وحده.
كما يُذكر أنَّ الإمام الحسين× لمّا نظر إلى اثنين وسبعين رجلاً من أهل بيته صرعى، التفت إلى الخيمة ونادى: يا سكينة ! يا فاطمة ! يا زينب يا أمَّ كلثوم! عليكنَّ مني السلام، فنادته سكينة: استسلمت للموت؟ فقال: كيف لا يستسلم مَن لا ناصر له ولا معين؟! فقالت: يا أبه ردَّنا إلى حرم جدِّنا، فقال: هيهات لو تُرك القطا لَنامَ([286])،
فتصارخت النساء، فأسكتهنَّ([287]).
وفي رواية أخرى قال الإمام الحسين×: «يا نور عيني كيف لا يستسلم للموت مَن لا ناصر له ولا معين؟! ورحمة الله ونصرتهُ لا تفارقكم في الدّنيا ولا في الآخرة، فاصبري على قضاء الله، ولا تشكي، فإن الدّنيا فانية والآخرة باقية»([288])، وهذا دليل على تعلّق السيّدة سكينة بأبيها، فهي ترغب في الرجوع إلى مدينة جدّها، كما أنَّ الحسين× أوصى ابنته بالصبر، ويطمئنُها بالوعد الإلهي، فيقول لها رحمة الله ونصرته لا تفارقكم. وتُعدُّ هذه الوصية الثانية من الإمام الحسين× لعزيزته سكينة.
ثمّ قال: ائتوني بثوب لا يُرغَب فيه ألبسه غير ثيابي؛ لئلا أُجرَّد، فإنِّي مقتول مسلوب، فأتوه بتبّان([289]) فأبى أن يلبسه، وقال: هذا لباس أهل الذلِّ، ثمّ أتوه بشيء منه دون السراويل وفوق الثياب فلبسه، ثمّ ودّع النساء، وكانت سكينة تصيح فضمّها إلى صدره([290])وقبَّل ما بين عينيها ومسح دموعها، وكان يحبُّها حبّاً شديداً، ثمّ جعل يسكّتها ويقول:
|
سيطولُ بعدي يا سكينة فاعلمي |
يرى البحراني: أنّ موقف الإمام الحسين× في حالته هذه دروس يجب أن يُستفاد منها، فيذكر أنّ الحسين× كان وقوراً، صبوراً، وتُعتبر مواقفه من المواقف الأخلاقية السامية، ومن معطيات الإيمان بالله واليوم الآخر، فهو يسلِّم ابنته سكينة وباقي النساء في رعاية الله سبحانه وتعالى([292]).
لقد كان الإمام الحسين× حريصاً جدّاً على نسائه، وكان دائماً ما يُوصي النساء بالصبر على المصائب، فقد رُويَ أنَّه× لمّا اشتدّ به العطش ذهب ليشرب الماء، ولمّا وصل اغترف الماء بيده وأراد أن يشرب، وإذا بعمر بن سعد قال: يا قوم وحقِّ بيعة يزيد إن رُوىَ الحسين× من الماء أفناكم جميعاً، فنادى خولي بن يزيد الأصبحي، يا حسين! خيمة الحريم أُحرِقت وأنت تشرب الماء، فنَفَضَ الماء من يده وركب جواده، وأقبل نحو الخيمة فوجدها سالمة، فعلم أنَّها مكيدة، وأمّا أمُّ كلثوم فقالت: يا سكينة قد جاءنا الماء، فخرجن جميعاً فرأوه وهو مخضَّب بدم الجراح، فصرخنَ بالبكاء والنحيب، فقال لهنَّ: تعزَّيْنَ بعزاء الله، ثمّ رجع يطلب الماء([293]).
كما رُوي أنَّه لما قُتل الحسين× جاء فرسه إلى خيمة النساء، فلما سمعنَ صهيله أقبلت زينب‘ على سكينة، وقالت قد جاء الماء فاخرجي إليه لتشربي، فخرجت فوجدت السرج خالياً، والجواد يصهل وينعي، فصاحت: واقتيلاه، واغريباه واحسيناه، هذا الحسين× بين العداء مسلوب العمامة والرداء، بدنه على الأرض، ورأسه مقطوع، واليوم يصير ماله وعياله بين الأعداء، آه من نار البلايا، غريباً لا يُرتجى وجريحاً لا يُداوى، ثمّ التفتت إلى الفرس فرأته يبكي ويصهل، فأنشدت:
|
فويلكَ يا ميمونُ فارجع بسـرعة |
من يقرأ هذه الأبيات الشعرية يفهم أنَّ القصيدة لأخت الحسين× وليست لابنته، خاصة وهي تنادي يا أخي، ولكنّي ـ أثناء البحث في الكتب التاريخية ـ لم أعثر على ترجمة لسكينة بنت علي÷، إلاّ أنَّ هذا لا يدلُّ على عدم وجودها، حيث تذكر بعض المصادر أنّه عندما استُشهدت الصدِّيقة الزهراء‘ قال الإمام علي× كفَّنتها وأدرجتها في أكفانها، فلمّا هممت أن أعقد الرداء ناديت يا أمَّ كلثوم! يا زينب! يا سكينة! يا فضة! يا حسن! يا حسين! هلمّوا تزوّدوا من أمِّكم؛ فهذا الفراق واللقاء في الجنّة ([295]).
هذا دليل على وجود سكينة للإمام علي× ولكن هل هذه الأبيات لسكينة بنت الإمام علي×، أم لسكينة بنت الحسين÷؟ إنَّ هذه الأبيات ـ إن صَحَّت ـ فهي للسيّدة سكينة بنت الحسين÷، وقد انفرد بها (الأسفراييني) دون غيره، وازدادت الأبيات الأخيرة من جهة أخرى، ممّا جعل القصيدة تبدو وكأنَّها للسيّدة سكينة بنت علي÷، كما أنَّي لم أعثر على دليل يؤكّد وجود السيّدة سكينة بنت علي÷ في واقعة الطف؛ وذلك لأنَّ جمع وتدوين تاريخ تراث أهل البيت^ كان مشتّتاً ومنقطعاً حتّى القرن الثالث للهجرة، وبدأ حينذاك تدوين التاريخ بشكل حقيقي وعلمي، ولهذا السبب نرى أنَّه لم يُذكر للسيّدة سكينة بنت علي÷ اسم في الكتب التاريخية المدوّنة، ولم يكن للمؤرِّخين رغبة في ذكر وشرح سيرة الأبناء والمنسوبين إلى الأئمة الطاهرين^ باستثناء المشهور منهم، والذين كان لهم دور كبير وبارز خلال الحوادث التاريخية، فمثلا هذا الجفاء التاريخي لم يشمل السيّدة زينب‘؛ لأنَّها كانت تخطب وتقف أمام الظلم الأموي الحاكم، وتحمل نفير وراية المعارضة في كلٍّ من كربلاء والكوفة والشام، حتّى أجبرت المؤرِّخين أن يذكروها ولو بأسطر قليلة ناقصة([296]).
ومن هذا المنطلق أُسندت هذه القصيدة إلى السيّدة سكينة بنت الحسين÷؛ لأنَّ لها مواقف وأدواراً لا يمكن أن يتجاهلها التاريخ، بينما السيّدة سكينة بنت علي÷ لم يذكروها ولا حتّى في أسطر قليلة، وبالتالي تكون السيّدة سكينة بنت علي هي الأخرى أخفاها التاريخ كما أخفى رقية بنت الحسين÷، على الرغم من أنَّ مرقد السيّدة سكينة بنت علي، والسيّدة رقية بنت الحسين÷ لا يزال موجوداً؛ ليظهر الحقّ على الرغم من إخفائه.
أمّا بخصوص الزيادات في الأبيات الأخيرة فأنسبها إلى الكاتب؛ إذ زاد على قصيدة الإمام الحسين× عندما أراد أن يودِّع السيّدة سكينة بثمانية أبيات([297]) بينما ذكرتها بقية المصادر بثلاثة أبيات فقط([298])، ومن ضمن الأبيات الثمانية بيت يقول فيه:
|
أوصيكِ بالولد الصغير وبعدَه |
وهذا يدلُّ على أنَّ الولد الصغير هو عبد الله، أخو السيّدة سكينة، فيوصيها الحسين× به، ولكنَّ الطفل الرضيع قبل الوداع الأخيركان مقتولاً؛ ممّا جعلني أشكُّ في روايته. وليس هذا فقط، بل أسندت قصيدة السيّدة سكينة إلى فاطمة بنت الحسين×، بينما ذكرتها المصادر لسكينة بنت الحسين÷([300])، وحتى لو كانت هذه القصيدة لسكينة بنت الإمام علي÷ فهذا لا يعني أنّ ليس للسيّدة سكينة بنت الحسين÷ موقف، أو دور عندما وصل خبر مقتل الإمام الحسين×، بل على العكس، لقد كانت للسيّدة سكينة قصائد ارتجلتها في نفس الوقت الذي علمت فيه باستشهاد أبيها، وسأذكر تلك القصائد بالتفصيل، وبالصيغ التي وردت فيها.
6ـ موقف السيّدة سكينة عند استشهاد الإمام الحسين×
عندما قُتِل الإمام الحسين× كانت ابنته السيّدة سكينة أوّل من علمت باستشهاده، يروي عبد الله بن العبّاس، قال: حدَّثني مَن شهد وقعة الطفِّ: أنَّ فرس الحسين× جعل يصهل على البدن المبارك ويقبِّله، فلمّا نظر إليه عمر بن سعد قال: لأصحابه خذوه وأتوني به، فلمّا علم طلبهم جعل يلطمهم برجله ويكدم بفمه حتّى قتل منهم خلقاً كثيراً، وطرح فرساناً عن ظهور خيولهم، فصاح عمر وقال: ويلكم تباعدوا عنه، ثمّ جعل يقبِّل البدن المبارك المكرَّم، ويمرِّغ ناصيته بالدم المطهَّر المعطّر ويصهل صهيلاً عاليا، وتوجَّه إلى الخيمة، فقالت أمُّ كلثوم: يا سكينة إنّي سمعت صهيل فرس أبيك، أظنُّ قد أتانا بالماء، فاخرجي إليه، فخرجت سكينة فرأته خالياً من راكبه، فهتكت خمارها، وصاحت: واقتيلاه، وامحمداه، واعلياه، واأبتاه، واحسيناه وافاطمتاه، واحمزتاه، واجعفراه، واعقيلاه، واعباساه([301])، وهي تنشد وتقول:
|
مات
الإمام ومات الجودُ والكرمُ اللهُ ربي من الكُفّار ينتقمُ |
فلمّا سمعت السيّدة زينب شعر السيّدة سكينة قالت: واأخاه واحسيناه، وبكت الحريم([303]).
لقد كانت السيّدة سكينة ترى في قتل الإمام الحسين×، انهيار البناء الهائل الكبير الذي أقامه جدُّها النبي في طول الأرض وعرضها؛ ليخلِّص البشرية من انحطاطها واندفاعها نحو الفوضى والشَّرِّ، فرأت بمصرع الحسين× مصرع الإمام القائد، والزعيم السياسي المثالي للأُمَّة الإسلامية، والرجل الذي قام برحلته الرامية إلى العراق من أجل الشهادة ومرضاة الله تعالى.
لقد كان موقف السيّدة سكينة عند استشهاد أبيها، حال أيِّ امرأة فقدت شخصاً عزيزاً من أسرتها، ومن ثمّ فإنَّ حياتها معرَّضة للسبي والذل من ناحية، ومن ناحية أخرى أنَّها فقدت المعيل الذي كان يتكفّلها، وهو رمز عزِّها ومجدها وسيفها الذي ترهب به الأعداء.
فيتّضح لنا من الرواية أنّ السيّدة سكينة هي أوّل مَن علمت باستشهاد أبيها، فعندما رأت الفرس وحده أيقنت بمقتل أبيها، فنادت بحزن عميق واجداه، واعلياه وافاطمتاه. وكأنَّها تريد إخبارهم بحال الحسين× وحال النسوة، وكان هذا النداء بمثابة إعلام للنساء بالإستعداد للبلاء الذي نزل بهنّ، والتهيُّؤ؛ لكي تقوم كلُّ امرأة بدورها الذي أتت من أجله.
فعبَّرت عن حزنها عن طريق الرثاء([304]) حيث مثّلت أصدق المشاعر الإنسانية وهي تواجه أقسى ضربات الدهر، حيث تفارق أعزّ النّاس إليها، فتحوَّلت دموعها ولوعتها إلى أبيات شعرية ترسم فيها معاناتها، وتترك بصمات الحزن على مدار التاريخ؛ لكي تترك في نفس سامعها أثراً عميقاً صادقاً؛ لتخبر النّاس عمّا عانته من أوجاع وكيف كانت حقيقة قاسية عليها.
فالرجل يمثِّل المعاني التي فرضت وجودها الحياة القاسية، لذلك فهي تفتقده وتحسُّ بخسارة الحامي والمسؤول والمدافع عنها([305]).
وعلى الرغم من صعوبة الموقف الذي مرّت به السيّدة سكينة إلاّ أنّها عبّرت برثائها، وصوّرت حالة الحسين× والقتلى بطريقة أدبية مرتجلة بأبيات خُلِّدت في الحسين× وفي واقعة الطف، وفي سيرة السيّدة سكينة‘.
وليس هذا فقط وإنّما أصبح طابع الرثاء هو الغالب على حزنها، فأخذت ترثيه دائماً حيث تقول:
|
لقد حطّمتْنا في الزمان نوائبُهْ |
كما ذُكرِ رثاؤها هذا في صيغة أخرى:
|
لقد حطَّمتْنا في الزمان نوائبُهْ |
وعلى الرغم من أنَّ الرثاء يمثِّل مدح الموتى والبكاء عليهم، إلاّ أنَّه يمثِّل حقيقة تاريخية، ويحمل صوراً شاهدت أحداثا حين وقوعها، فقصيدتها واضحة، حيث تمثّل فيها أقسى اللحظات التي عانتها السيّدة، وتصوّر فيها المصائب والنوائب مستخدمة عبارات قاسية كالأنياب والمخالب، كما تصوّر مقتل الحسين× وحاله وهو قتيل فتقول: «تداعت جوانبه»([308])، وتصور حالها بأحلى العبارات وأغربها مصوّرة الحسين× في جزئها الآخر، فتقول: «جانب حي وقد مات جانبه»([309])، كما تستنكر مقتله مستفهمة:
|
تمزقنا أيدي الزمانِ وجدُّنا |
كما أنَّ هناك رثاءً آخر للسيّدة سكينة رثتْ به أباها الحسين× قائلة:
|
لا تعذليه فَهَمٌّ قَاطعٌ طرقَهْ |
لقد رثت السيّدة سكينة‘ أباها مرّة أخرى، لكن بأسلوب أصعب، وببلاغة واضحة، فهي ترتجل قصائد معبِّرة عن حزنها فيها، ولقد استخدمت كلَّ المقوِّمات الأدبية فيها، وهذا دليل على تربيتها على تلاوة القرآن بالشكل الصحيح.
إنَّ قول السيّدة سكينة بنت الحسين÷ لا تعذليه([312])، كانت تعني به أنَّ الهمَّ القاطع كان سبباً للدموع التي تلائم مطالع قصائد الرثاء هذه؛ لأنَّها جاءت استجابة للعاطفة الصادقة المتّفقة التي تكنُّها البنت لأبيها، كما تحاول أن تفصح عن مكنون صدرها المشحون بالأحزان والآلام؛ إذ إنَّها تحاول أن تجد لهذه الهموم متنفَّساً، فلجأت إلى هذه القافية الساكنة، كما استعملت حرف (يا) النداء من باب أنّها تلحُّ على العين وتدعوها إلى البكاء دماً بدل الدموع، لأنَّها ترى العين لم تستجب بإرسال الدموع، فألحَّت عليها عسى أن تلبيَ ما يجيش في صدرها من ألم وحزن، كما أرادت إظهار استحقاق الحسين× بحكم قرابته من رسول الله| دون غيره؛ بأن يُحزَن عليه طول الحياة، فوظَّفت استعمال نسبته إلى رسول الله|([313]).
لقد استطاعت السيّدة سكينة أن تعبِّر عن حزنها بطريقة لا يمكن أن يتجاهلها التاريخ؛ فقد استمرَّت هذه القصائد عبر التاريخ تشرح ما في داخلها من طبيعة حزن السيّدة سكينة، معبِّرة عن كلِّ الأحداث التي مرَّت بها، وخاصّة عندما تقول:
|
أبي يا أبي يا خيرَ ذخرٍ فقدتُهُ |
7ـ موقف السيّدة سكينة من حرق الخيام
لما استُشهِد الإمام الحسين× توجَّه عسكر ابن سعد إلى الخيام لسلب النساء، حتّى ذُكِر أنَّ شمراً قصد الخيام، فنهبوا ما وجدوا حتّى قطعتْ أُذن أُمِّ كلثومَ الحلقة ([315]).
مال النّاس على ثقله ومتاعه، ونهبوا ما في الخيام، فكانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتّى يُغلب عليه، فيُذهَب به منها([316])، وإنَّ المرأة لَتُسلب مقنعتها من رأسها وخاتمها من إصبعها، وقرطها من أذنها، والخلخال من رجلها([317]).
في هذا الوقت هربت النساء إلى الصحراء، وخرجت السيّدة سكينة إلى ساحة القتال، فوجدت أباها مقتولاً مذبوحاً، فاعتنقت جسده الشريف×، فاجتمع عدّة من الأعراب حتّى جرّوها عنه([318])، ولقد رُوي بسندها أنّها قالت: لمّا اعتنقته أُغمي عليَّ فسمعته يقول:
|
شيعتي ما إنْ شربتُم ريَّ عذبٍ فاذكروني |
فقامت مرعوبة قد قَرِحَت مآقيها، وهي تلطم على خدّيها وإذا بهاتف يقول:
|
بكتِ الأرضُ والسماءُ عليه مُنِعَ الماء وهو عنه قريبٌ |
ويذكر المازندراني: «اهتزَّ العرشُ، كاد يخرُّ يوم وقعت سكينة على جسد الحسين×»([321]).
لقد رمت السيّدة سكينة نفسها على جسد الحسين×، طالبة منه الأمان من حريق وشدّة الأعداء وفقدان الولي، عسى أن ينهض ليذبَّ عن حرم رسول الله، تبكي بحرقة تراه مقطّعاً مذبوحاً، لم تنسَ السيّدة سكينة هذه لحالة طول عمرها، وأخذت تروي هذه الرواية على مدار سبعين عاماً.
ونعتقد أن أقسى ليلة مرّت على السيّدة سكينة كانت ليلة الحادي عشر من المحرم، ولو نتصوّر المشاهد الدامية التي كانت تشاهدها السيّدة لمعرفتنا بشدّة المأساة التي مرّت عليها، حيث ترى الحسين× مجزَّراً مع إخوته وأبنائه وأهل بيته، وهم على مقربة من مخيّم النساء والأطفال، يصاحب ذلك صهيل خيل عسكر ابن زياد، ونار أحرقت الخيام، وما رافق ذلك النهار من عطش وحزن، أخذت السيّدة سكينة تنظر إلى السيّدة زينب‘ وهي تواجه أقسى ضربات الدهر بإيمان وصبر.
ووسط كلِّ تلك الأهوال اتجهت السيّدة زينب‘ إلى الله عز وجل لتأدية صلاة الشكر بإيمان صحيح لا يشوبه شكّ؛ لأنَّها كانت تنظر إلى تلك الأحداث على أنّها نعم خصَّ الله بها أهل بيت النبوّة من دون النّاس أجمعين([322])، ومن هنا أيقنت السيّدة سكينة أنَّ دور النساء العلويات قد بدأ، فأخذت تسير على خطى عمَّتها.
ينقل لنا الخلخالي: «استيقظت السيّدة زينب‘ من النوم وأخذت تدعو السيّدة رقية‘ فلم تجبها، فخرجت مع السيّدة أم كلثوم تبكيان وتبحثان عنها، وبينما هما كذلك وإذا هما بصوت السيّدة رقية‘ بين القتلى، فتوجّهتا نحو القتلى وإذا بالسيّدة رقية‘ قد ألقت بنفسها على جسد أبيها وهي تشكو إليه ما جرى، فهدّأتها السيّدة زينب‘ ورفعتها عن جسد والدها، ولم تمض لحظات وإذا بالسيّدة سكينة تأتي فرجعوا معها، وفي أثناء الطريق التفتت السيّدة سكينة إلى السيّدة رقية‘وقالت: كيف وجدتِ جسد أبي؟ فأجابتها السيّدة رقية‘: بينما كنت أصيح في البيداء أبتاه.. أبتاه.. إذا بصوت والدي يتهادى إلى سمعي قائلا: بنية إليَّ إليَّ...»([323]).
من هنا بدأ الدور الفعلي للسيّدة سكينة‘، وأخذت تسير على نهج عمّاتها وتتبعهنّ، وأدركت بأنَّ الدور الفعلي والريادي للسيّدة زينب وأم كلثوم قد بدأ، فأخذت تتفقدهما في هذه الليلة وأخذت تبحث عنهما، وهي تعلم أنَّ عمّتها خرجت من أجل البحث عن أحد الأطفال، فخرجت عسى أن ترى أباها مرّة أخرى، فلمّا وجدت السيّدة رقية× سألتها عن حال أبيها، عسى أن يطفئ هذا الخبر الحزن والأسى.
ثالثاً: أدوار السيّدة سكينة بعد معركة الطف
1ـ دور السيّدة سكينة في مجلس يزيد بن معاوية
لقد أمر يزيد بن معاوية بإدخال السبايا إلى مجلسه، وكان أوّل مَن أُدخِل هو علي ابن الحسين×، وكانت يداه مغلولتين إلى عنقه([324])، ثمّ أُدخِلت النساء، عندها قالت سكينة: «يا يزيد أبنات رسول الله سبايا؟ قال يزيد: يا بنت أخي هو والله عليَّ أشدّ منه عليك...»([325])، وبهذا التصرّف تواجه السيّدة سكينة يزيد بكلِّ صلابة، وتجبره على التراجع في مواقف، بحيث يظهر الندامة ويجعل المسؤولية على عاتق ابن مرجانة كذباً وزوراً([326]).
إنَّ كلام السيّدة هذا كان نابعاً من ثقة في النسب وعلوٍّ في النفس، فأرادت أن تذكّره بأنهنَّ بنات رسول الله|، كما استنكرت الموقف بكلِّ جرأة وقابلية؛ فنادته مستحقرة إيّاه بقولها: (يا يزيد)، على الرغم من صغر سنِّها والحالة الصعبة وهي في مجلسه أسيرة، فنلاحظه يندم ويسمِّي الإمام الحسين× بـ (أخي)، فكان كلام السيّدة توبيخاً وإلقاء للحجّة عليه، وإعلامه بكثرة أخطائه، وأكثرها سبي النساء.
ثم وُضعت الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأس الإمام الحسين×، ثمّ أدخل نساء الحسين×، فجعلت فاطمة وسكينة ابنتا الحسين^ تتطاولان؛ لتنظرا إلى الرأس، فما كان على يزيد إلاّ أن يتطاول ليستر عنهما الرأس، فلمّا رأين الرأس صحن([327]).
إنّ سبب منع يزيد السيّدة سكينة وأختها السيّدة فاطمة من رؤية رأس الحسين×؛ خوفاً من أنْ يثير هذا الموقف حزن النساء في المجلس من الهاشميات وغيرهنَّ من النسوة، وبالتالي يثير صراخهن الرأي العام، ويزداد النّاس في توبيخ يزيد وأعوانه.
إلا أنَّ هناك رواية روتها السيّدة سكينة‘ لما أُدخلت النساء مجلس يزيد، وضع يزيدُ رأسَ الحسين× بين يديه، فقالت سكينة‘: والله ما رأيت أقسى قلباً من يزيد، ولا رأيت كافراً ولا مشركاً شرّاً منه، ولا أجفى منه، وأقبل يقول وهو ينظر إلى الرأس:
|
ليتَ أشياخي ببدر شهدُوا |
لقد حدَّدت السيّدة سكينة‘ شخصية وسلوك يزيد، وبكلامها هذا جعلت منه رجلاً أكثر من كافر ومشرك، حيث صرّحت بكفره وزندقته وإلحاده، وبالتالي هذه كلمة عدل أمام سلطان جائر.
وأضاف الخلخالي حول رواية السيّدة سكينة قائلة: «لم أُطق تحمّل هذا العمل الشنيع منه، وألقيت بنفسي على الرأس الشريف، فخاطبتُ يزيد: ما ذنب هذا الرأس حتّى تضربه؟ فتعجّب يزيد اللعين من جرأتها، وتساءل قائلاً: مَن أنتِ؟ فقلت: أنا سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب»([329]).
هكذا تدافع السيّدة سكينة عن رأس أبيها، وهي بدفاعها هذا تكون قد تحدّت الطاغية في عقر داره، وأثبتت عدوانه على أهل البيت([330]).
أراد يزيد أن يضرب رأس الإمام الحسين× حتّى يقهر الإمام السجاد× وباقي النساء([331])، وعندما رأت السيّدة سكينة هذا الفعل ثار غضبها، وقامت تحاججه بكلِّ ثبات ونضج ، حيث قالت: ما ذنب هذا الرأس؟ فأثار كلامها وتصرفها هذا انتباه يزيد فسأل عنها مَن تكون؟
ونرى مواجهة أخرى تُعدُّ من أقوى الأدوار السياسية التي قامت بها السيّدة سكينة في مواجهة يزيد، فعندما أمر يزيد بإحضار السبايا، وأُحضروا بين يديه جعل ينظر إليهنَّ ويسأل مَن هذه ومَن هذا؟ فقيل له: هذه أمُّ كلثوم الكبرى، وأمُّ كلثوم الصغرى... وسكينة وفاطمة بنتا الحسين بن علي، وهذا علي بن الحسين، فالتفت يزيد إلى سكينة، وقال: يا سكينة أبوك الذي كفر حقِّي، وقطع رحمي، ونازعني ملكي، فبكت سكينة وقالت: لا تفرح بقتل أبي؛ فإنَّه كان مطيعاً لله ولرسوله، ودعاه إليه فأجابه وسعد بذلك، وإنّ لك يا يزيد بين يدي الله مقاماً يسألك عنه، فاستعد للمسألة جواباً وأنّى لك الجواب؟! قال لها: اسكتي يا سكينة، فما كان لأبيك عندي حقٌّ([332]).
من الملاحظ أنَّ السيّدة سكينة لم يبدُ عليها الضعف والخوف والانكسار، وهي تقف أمام رأس السلطة الأموية بجرأة وثبات وقوة إيمان، دون أن يدركها ما يدرك مثيلاتها من النساء، فاستطاعت أن تحطِّم نشوة النصر الذي يفتخر به يزيد، على الرغم من صغر سنِّها وكونها امرأة ضعيفة، فقدت أحبابها، وجاءت أسيرة مقيَّدة بحبال الأسر.
ثمّ وَثَبَ رجل من العجم وقال: يا أمير هَبْ لي هذه الجارية؛ لتكون خادمة عندي (يعني سكينة)! فانضمَّت إلى عمّتها أمِّ كلثوم، وقالت: يا عمتاه أترين نسل رسول الله يكونون مماليك للأدعياء؟ فقالت أمُّ كلثوم لذلك الرجل: اسكت يا لكع الرجال، قطع الله لسانك، وأعمى عينيك، وأيبس يديك، وجعل النّار مثواك، إنَّ أولاد الأنبياء لا يكونون خدمة لأولاد الأدعياء، فلم يستتمَّ كلامها حتّى استجاب الله دعاءها في ذلك الرجل، فقالت: الحمد لله الذي جعل لك العقوبة في الدّنيا قبل الآخرة، فهذا جزاء مَن يتعرَّض لحُرم رسول الله([333]).
وهذا تصرّف آخر للسيّدة سكينة يدلُّ على احتجاجها على موقف السلطة الظالمة، فهي تأبى أن تكون جارية، فتعطى درساً في التحرّر وعدم القبول بالذل، وهي بنفس الوقت تأبى كلَّ من يقف ضدَّ الحرية ويناصر العبودية والذل، موضّحة أنّ أولاد الأنبياء هم أسياد، ولا يكونون خدماً لأحد.
كما توضّح الرواية كرامات نساء آل بيت النبوّة، فسرعان ما استجاب الله لدعاء السيّدة أمِّ كلثوم، فعاقب الرجل. لقد خصَّ الله هؤلاء النسوة بكرامات، وكانت أمام النّاس واضحة عسى أن يفهم الظالمون مكانة هؤلاء عند الله تعالى.
2ـ دور السيّدة سكينة في المواجهة والاحتجاج
حصلت في مجلس يزيد مجموعة من المواجهات والاحتجاجات بين السيّدة أمِّ كلثوم وهند أخت يزيد، وبين زوجة يزيد أمِّ حبيب وشاه زنان أمِّ زين العابدين÷، ومن بين المواجهات مواجهة السيّدة سكينة‘ وعاتكة بنت يزيد([334])، حيث أخذت السيّدة سكينة تزداد شجاعة وثقة؛ لتأثّرها بمَن حولها من النساء، فنلاحظها تقف ببطولة، تهزُّ المجلس بعباراتها وفصاحتها وكأنَّها ملقَّنة بهذا الكلام.
فقد ذُكر أنَّ عاتكة بنت يزيد وثبت على قدميها، ثمّ نادت: أيتكُنَّ سكينة بنت الحسين؟ فقالت: أنا المطالبة بثأر بدر وحنين، ويلك أنتم بنا مستهزؤون، وبما نزل بنا شامتون، فنحن من أهل بيت المصائب، وأبونا على بن أبي طالب، فمَن أنتِ يا ويلك؟ قالت عاتكة :بنت يزيد، صاحب العزِّ الشامخ، والذكر الباذخ، أهل الحقِّ والديانة. فقالت لها سكينة: ويلك مهلا، إنَّ الله تعالى جعل الدّنيا دار بلوى، وجعل الآخرة لِمَن ناوء الدّنيا، ولستم يا ويلك مثلنا، أليس أبوك المفتخر بقتل آل محمد| ظلماً؟ وأمُّك المعتكفة لعبدها؟ فعليك وعليها لعنة الله، فأمّا نحن فأهل بيت الأحقاف، ورجالنا أهل الأعراف، والصفوة من آل عبد مناف، فلم تجبها حينئذ عاتكة وقد أُلقمت بحجر([335]).
إنَّ الدور البطولي للسيّدة سكينة هنا لا يتجزّأ عن أدوار النساء العلويات، فقد رَجَّت مجلس يزيد، وأسكتت النساء وبنت يزيد، فكان مدخل السيّدة في المواجهة قوياً جداً؛ فإنّها تدخل ثائرة ومطالبة ببدر وحنين، وهذا دليل على أنَّ السيّدة سكينة كانت تنتظر هذا الدور، فمجرّد أن سألت عاتكة عن السيّدة واجهتها، وكانت بداية الكلام لها، كما استعملت السيّدة سكينة كلمة ويلكِ، وهذه كلمة دعاء بسوء([336])، وقد كررتها السيّدة عدّة مرات، وذكّرتها بأنّهم معتادون على المصائب، كما وذكّرتها بنسبها الطيب العريق قائلة: أبونا علي بن أبي طالب، وتردُّ على عاتكة التي تفتخر بسلطة وعِزِّ أبيها ردّ عالمة متعلّمة؛ فتذكِّرها بأنَّ الدّنيا دار بلوى، وتوبخها وتشتمها فتقول: يا ويلكِ لستم مثلنا، شارحة الفرق والتعريف بالعائلتين، فتشرح لها مختصرة خزي عائلتها وتاريخها وتعرّفها بعراقة عائلة الحسين×.
كما خصَّ الله تعالى السيّدة سكينة‘ برؤية رأتها في منامها وهي في دمشق، تحديداً في يوم دخولها دمشق([337])، وقد نُقِلت هذه الرؤيا بصيغ مختلفة إلاّ أنَّ المغزى منها واحد على الرغم من الاختلاف؛ إذ رُوي أنّ السيّدة قالت: يا يزيد رأيت البارحة رؤيا إن سمعتها منّي قصصتها عليك، فقال يزيد: هاتي ما رأيتي، قالت: بينما أنا ساهرة وقد كللت من البكاء، وبعد أن صلّيت ودعوت الله دعوات، وإذا بالمنام خمس نُجُب من نور قد أقبلت، وعلى كلِّ نجيب شيخ والملائكة محدِقة بهم، ومعهم وصيف يمشي، فمضت النُجُب وأقبل الوصيف إليَّ وقَرُب منّي، وقال: يا سكينة إنَّ جدّك يسلِّم عليك، فقلت: وعلى رسول الله السلام، يا رسول مَن أنت؟ قال: وصيف من وصائف الجنّة، فقلت مَن هؤلاء المشيخة الذين جاؤوا معك على النُجُب؟ قال: الأول آدم صفوة الله، والثاني إبراهيم خليل الله، والثالث موسى كليم الله، والرابع عيسى روح الله، فقلت: مَن هذا القابض على لحيته يسقط مرّة ويقوم أخرى؟ فقال: جدُّكِ رسول الله|، فقلت: وأين هم قاصدون؟ قال: إلى أبيك الحسين×، فأقبلتُ أسعى في طلبه لأعرّفه ما صنع بنا الظالمون بعده، فبينما أنا كذلك إذ أقبلت خمسة هوادج من نور، في كلِّ هودج امرأة، فقلت مَن هذه النسوة المقبلات؟ قال الأولى حوّاء أمُّ البشر، والثانية آسيا بنت مزاحم، والثالثة مريم بنت عمران، والرابعة خديجة بنت خويلد، والخامسة واضعة يدها على رأسها تسقط مرّة وتقوم أخرى، فقلت: مَن هذه؟ فقال: جدّتك فاطمة بنت محمّد أمُّ أبيك، فقلت: والله لأخبرنَّها ما صُنِع بنا، فلحقتُها، ووقفت بين يديها أبكي وأقول: يا أُمّاه جحدوا والله حقّنا، يا أُمّاه بدَّدوا والله شملنا، يا أُمّاه استباحوا والله حريمنا، يا أُمّاه قتلوا والله الحسين أبانا، فقالت: كُفِّى صوتك يا سكينة فقد أحرقت كبدي، وقطَّعتي نياط قلبي، هذا قميص أبيك الحسين معي لا يفارقني حتّى ألقى الله به، ثمّ انتبهت وأردت كتمان ذلك المنام، وحدّثت به أهلي فشاع بين النّاس([338]).
كما ذُكرت الرؤيا بصيغ أخرى، حيث قال الراوي: «لما سكن الرَّوع قالت سكينة: اعلم يا يزيد أنّي كنت البارحة بين النوم واليقظة، إذ رأيت قصراً من نور، شرفاته من الياقوت، وإذا بباب قد فُتح فخرج منه خمسة مشايخ قد عظّم الله تعالى أجورهم، وزادني نورهم، يقدمهم وصيف، فتقدّمت إليه وقلت: يا فتى لِمَن هذا القصر؟ فقال لأبيك الحسين×، قلت: ومَن هؤلاء المشايخ؟ فقال: هذا آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وبينما هو يخاطبني إذ أقبل رجل قمريُّ الوجه كأنّه قد اجتمع عليه همُّ الدّنيا، وهو قابض على لحيته، فقلت: مَن هذا؟ فقال جدُّك رسول الله|، فدنوت منه وقلت له: يا جدّاه، قد قُتِلت والله رجالنا، وذُبِحت والله أطفالنا، وهُتِكت والله حريمنا، فانحنى عليَّ وضمَّني إلى صدره، وبكى بكاءً عالياً، فأقبل إبراهيم وآدم ونوح وموسى وعيسى وقالوا: اخفضي من صوتك يا ابنة الصفوة، فقد أوجعت قلب سيدنا رسول الله|، ثمّ أخذ الوصيف بيدي وأدخلني القصر، وإذا بخمس نسوة كالبدور الطالعة وبينهنَّ امرأه ناشرة شعرها، وقد صبغت أثوابها بالسواد، وبين يديها قميص مضمّخ بالدم، إن هي قامت قُمنَ النساء معها، وإن جلست جلسنَ معها، وكانت تحثو التراب على رأسها مرّة بعد مرّة تكاد تذوب مهجتها، قد احترق قلبها لمصاب الحسين×، فقلت للوصيف: فمَن هؤلاء النسوة؟ قال: هذه حواء ومريم وأمُّ موسى وآسيا وخديجة الكبرى، وصاحبة القميص المضمَّخ بالدم جدّتُك فاطمة الزهراء، فدَنَوتُ منها، وقلت لها: يا جدّتاه قُتل والله أبي وإيتُمتُ على صغر سنّي، فضمَّتني إلى صدرها، وقالت: يعزُّ والله عليّ ذلك، وصرخت وقالت: أحرقتِ قلبي يا سكينة، مَن غسّل ابني؟ مَن كفّنه؟... مّن صلّى عليه؟ مّن جهّزه؟ مَن سار بنعشه؟ مَن حفر له قبره؟ مَن تحفّى له؟... مَن لحّده في لحده؟... مَن أشرج عليه اللبن؟ مَن أهال التراب على ولدي وقرّة عيني الحسين؟ مَن تكفّل أيتامكم يا سكينة بعده؟ مَن حنّ عليكم بعوائد اللطف؟ مَن تكفّل أراملكم.. ؟ ثمّ قالت وا ولداه... وا مهجة قلباه، وا ثمرة فؤاداه... فتناوحت النساء من حولها حتّى ظننت أنَّ القصر يريد أن ينطبق، وهي من عبرتها تختنق، فجعلت النساء يعزينها تعزية شديدة ويهدِّئنها، ولم تكن تهدأ، وكأنَّها أخذت حزن أهل الدّنيا على رأسها، والنساء يقلنَ لها: يا فاطمة سلام الله عليكم، يحكم الله تعالى بينكم وبين يزيد وهو خير الحاكمين، وودّعتني وهي باكية، فانتبهت وَجِلَة قد زادني حزناً إلى حزني»([339]).
كما ذُكرت هذه القضية على وجه آخر: «إنّ الحريم لمّا أُدخِلوا في السبي على يزيد كان يتطلّع فيهنَّ ويسأل عن كلِّ واحدة بعينها... فقال يزيد لسكينة: ارجعي مع النسوة حتّى آمر بكنَّ أمري، فقالت: يا يزيد إنَّ بكائي أكثره من طيف رأيته الليلة، فقال: قصِّيه عليّ، فأمر السائق بالوقوف، فقالت: إني لم أنم منذ قُتل أبي الحسين؛ لأنّي لم أتمكّن من الركوب على ظهر جمل أدبر أعجف، هذا وكلّما عثر بي يقهرني زجر بن قيس، ويوبّخني ضرباً بالسوط، فلم أرَ مَن يخلِّصني منه، فلعنه يزيد وجلساؤه، ثمّ قالت: رقدت الليلة وإذا بي أرى قصراً من نور، شرائفه من الياقوت، وأركانه من الزبرجد، وأبوابه من العود القماري، فبينما أنظر إليه وإذا ببابه قد فُتِح، وخرج منه خمسة مشايخ يقدمهم وصيف... قالت: يا جدّاه لو رأيتنا على الأقناب بغير وطاء ولا غطاء ولا حجاب، ينظر إلينا البَرُّ والفاجر، لرأيتَ أمراً عظيماً وخطباً جسيماً، فانحنى عليَّ وضمَّني إلى صدره... فدَنَوتُ منها وقلت: السلام عليكِ يا جدّتاه... قالت: يا سكينة ما حال العليل؟ فقلت: يا جدتاه، مراراً كثيرة أرادوا قتله، فدفعتهم عنه علَّتُه، لأنّه مكبوب على وجهه، قد سلبوه ثيابه، فلا يطيق النهوض، ولو ترينه حين أركبوه على ظهر أعجف أدبر، وقيّدوا عنقه بقيد ثقيل، فبكى، فقلنا له: ما يبكيك؟ قال: اذا رأيت قيدي هذا ذكرت أغلال أهل النار، فسألهم فكّه، فقيّدوا أيضاً رجله من تحت بطن الناقة، وإذا بفخذه يسيل دماء وقيحاً...»([340]).
إنَّ هذه الرؤيا لها أثر كبير، فقد هزّت مجلس يزيد، فخشي أن يثير هذا الخبر الرأي العام، وأخذ يفكر في إطلاق سراحهم، وممّا زاد قلقه رؤيا رأتها هند زوجة يزيد([341]).
ترى الباحثة أنَّ السيّدة سكينة رأت الرؤيا في اليوم الرابع من دخولهم دمشق، فبقوا مدّة طويلة حتّى عادوا إلى المدينة، وباعتقادي أنَّ هذه الرؤيا تردَّدت أثناء هذه الفترة على السيّدة سكينة أكثر من مرّة، لذلك جاءت الرؤيا بصيغ مختلفة، وبكلّ مرّة رأت رؤيا توضّح حال أهل السماء، ممّا جعل الرؤيا واضحة، ومكمّلة واحدة للأخرى، وبالتالي فإنّ قص الرؤيا على يزيد في كلّ مرّة كان يحمِّله مسؤولية وتوبيخاً، ممّا جعل يزيد يطلق سراح الأسارى.
أمّا المغزى من هذه الرؤيا فهو واضح بكلِّ صيغها، فعبّرت عن حزن الأنبياء وحزن النبي، والسيّدة فاطمة الزهراء، وكيف يواسي الأنبياء النبيَّ محمداً، كما شرحت السيّدة سكينة ما لقته من ضرب أثناء السير، كما شرحت معاناة زين العابدين× وكيف كان مقيّداً بالحبال، وليس هذا فقط بل كانت لديها جرأة وشجاعة لمواجهة يزيد، وقصَّت الرؤيا بكل تفاصيلها، وهي تناديه يا يزيد، وبهذا التصرُّف ألقت اللوم والحجّة عليه؛ لكي تنبّهه على الجريمة التي ارتكبها، وكيف أغضبت أهل السماء، وخاصّة عندما رأت السيّدة الزهراء تحتفظ بالقميص حتّى يحاكم اللهُ يزيدَ. وبعد أن قصّت السيّدة سكينة هذه الرؤيا أمر يزيد بتهيئة دار للنساء، وأعطاهنَّ كلَّ شيء يحتجْنَ إليه، ولم تبقَ في دمشق قرشيّة إلاّ لبست السواد، يبكينَ على الحسين× سبعة أيام، فلمّا كان اليوم الثامن عُرضنَ عليه فخيرهنَّ بين المقام عنده والسير إلى المدينة المنورة، فاخترنَ السير إلى المدينة ([342]).
3ـ دور السيّدة سكينة عند الرجوع إلى كربلاء
لمّا رجعت نساء الحسين× من الشام إلى كربلاء وبلغوا العراق، قالوا للدليل: مرَّ بنا على طريق كربلاء، فوصلوا إلى موضع المصرع، فوجدوا جابر بن عبد الله الانصاري([343]) وجماعة من بني هاشم، ورجالاً من آل الرسول| قد وردوا لزيارة قبر الحسين×، فوصلوا في وقت واحد، وتلاقوا بالبكاء والحزن واللطم، وأقاموا المآتم المقرحة واجتمعت إليهم النساء([344]).
أقاموا المآتم عند قبر الحسين× ثلاثة أيام، فلمّا كان اليوم الرابع توجّهوا نحو المدينة، ولمّا أرادوا الرحيل وجاؤوا بالجمال للنساء صاحت رقية بنت الحسين÷ بالنساء: ألا ارجعن إلى قبر أبي لنودِّعه، فرجعن إليه ودرنَ حوله، فاحتضنت القبر الشريف وبكت بكاء شديداً حتّى غُشى عليها، فلمّا أفاقت جعلت تنشد وتقول:
|
رحلنا يا أبي بالرغمِ منّا |
يتّضح من هذه الرواية أنَّ رقيَّة بنت الإمام الحسين÷ ألقت بنفسها يوم الأربعين، بيد أنَّ السيّدة رقية استُشهدت في مجلس يزيد والقصّة معروفة. كما أنّها ليست فاطمة بنت الحسين÷؛ لأنّ السيّدة فاطمة‘ كانت معروفة، وكان لها خطبة في الكوفة وأدوار كثيرة في واقعة الطّف وما بعدها، فلا اعتقد أن يُخلَط بينهما، وعليه فإنَّ المقصود في الرواية هي السيّدة سكينة بنت الإمام الحسين÷.
4ـ الدور الإعلامي للسيّدة سكينة‘
بعد ما قُتل الحسين× بعث عمر بن سعد برأسه ـ في اليوم الذي قُتل فيه مع خولي بن يزيد الأصبحي وحميد بن مسلم الأزدي ـ إلى عبيد الله بن زياد، فأقبل به خولي فأراد القصر فوجد القصر مغلقاً([346])، وأمر برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته فقُطعت، وأسرع بها مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج، فأقبلوا حتّى قدموا بهذه الرؤوس إلى الكوفة، وأقام ابن سعد بقيّة يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس، ثمّ رحل بعيال الإمام الحسين×، وحمل نساءه على أقتاب الجمال بغير وطاء مكشّفات الوجوه بين الأعداء، وهنَّ ودائع الأنبياء، وساقهنَّ كما يُساق سبي الترك والروم في أشدِّ المصائب والهموم([347]).
ومن هنا بدأت مرحلة السبي، وكانت من أقسى وأشدِّ المراحل التي مرّت بها النساء، حيث لم تراعِِ السلطة الأموية حرمة رسول الله|، رجعت من دون الرجال والأخوة، يُساقون كما تُساق سبايا الروم، كما أنَّ مسير السبايا من كربلاء إلى الكوفة ثمّ إلى دمشق، ولم تكن هذه المسافة بالقليلة، وطول هذه المسافة عانت السيّدة سكينة الكثير من المآسي، وهي تسير حسب ما ترغب السلطة الأموية، لكنّ قلبها ينظر إلى كربلاء حيث تترك أعزّ ما تملك (الأهل والأخوة) وتستقبل البلاء بكلِّ إيمان وصبر، وترى أنّ هذا البلاء من نعم الله التي خصّ بها آل بيت النبي|.
وفي أثناء المسير قامت نساء بيت النبوّة بأروع الأدوار التي بقيت خالدة، والسيّدة سكينة تنظر بأمِّ عينها إلى ما تقوم به السيّدة زينب وباقي النسوة من أدوار، وهي تزداد ثقة وإيماناً، وتسير على نهج السيّدة زينب‘، فتراها تتحمّل أشدَّ الآلام.
وفي هذه الأثناء كانت الرؤوس تسير أمام السيّدة سكينة، وهي تنظر إليها وتعلم بأنَّ هؤلاء الأبطال أدّوا ما عليهم، ورجعوا إلى مضاجعهم، فيذكر الخلخالي: «... كما جعلوا رأس علي الأكبر والقاسم قبال عيني سكينة وفاطمة، وكانوا يلعبون بالرؤوس، وكانت الرؤوس تهوي على الأرض أحياناً وتصبح موطأ لأقدام الخيول»([348]).
كانت السيّدة سكينة مؤمنة بالله صابرة، تحمَّلت ثقل الحبال وضرب الأسواط والجوع والعطش، فقد رُوي عن الإمام زين العابدين× أنّه قال: لما أرادوا الوفود بنا على يزيد أتونا بحبال وربّطونا، وكان الحبل بعنقي وعنق أمِّ كلثوم وبكتف زينب وسكينة والبنات، وساقونا، وكلّما قصرنا عن المشي ضربونا حتّى أوقفونا بين يدي يزيد([349]).
وفي أثناء الطريق كانت للسيّدة زينب والسيّدة أمّ كلثوم وباقي النساء خطب ذات مدلول سياسي واجتماعي فعّال، بينما السيّدة سكينة لم يُتَح لها ما أُتيح لآل الحسين× من الظهور على سوح الأحداث في كربلاء والكوفة والشام، لتُلهِب الأجواء بالخطب والبيانات؛ لأنَّ مهمّة ذلك موكلة إلى الكبار من أهل هذا البيت الطاهر، فمع وجود أخيها الإمام زين العابدين×، وعمّتها زينب، وأم كلثوم، وأختها فاطمة، لم يبقَ لها دور في ذلك، لأنّها كانت في أعداد الهاشميات الصغيرات، والمخدَّرات اللواتي لم يتحمّلنَ مهمّة التبليغ بعدُ، ولم تظهر إلاّ بعد أن حطَّ الآل ركابهم في المدينة، وأخذت تستذكر فيما بعد أحداث الفاجعة، لتروي لنا نُتفَاً ممّا علقت بها ذاكرتها من محن وأحداث([350]).
إلا أنّ هذا لا يعني أنَّ السيّدة لم تقم بأيّ دور، فقد قامت بدور إعلامي بحت؛ لكشف أكاذيب بني أميّة وكشف حقائقهم، حيث كانت أهداف السلطة الأموية من التشهير بسبايا أهل البيت هو إرعاب النّاس حتّى لا يفكر أحد في معارضة السلطة أولاً، ولتعبئة الجمهور ضدّ الإمام الحسين× وثورته ثانياً، وذلك بإظهاره خارجياً متمرِّداً قد شقَّ عصا المسلمين؛ طمعاً في السلطة والحكم، ولكنّ وجود العارفين بفضل أهل البيت على الأمة، والحالة المأساوية للسبايا، والتي كانت تثير مشاعر التعاطف معهم، والدور الرسالي الذي قامت به بعض نساء العائلة الحسينية؛ كلُّ ذلك أفشل مخطّط السلطة ([351]).
حيث إنَّ الإعلام الأموي كان يهدف إلى استغلال النّاس، وجعلهم يرضون بعقيدة القضاء والقدر، وبالتالي يمنعون النّاس من الحركة أو الثورة، وبذلك سيستمر الظلم بكلِّ مظاهره من الطغيان الداخلي والقهر الخارجي، وانحياز وضياع استقلال الأمّة وحريتها([352]).
ظنّ النّاس أنَّ هذه السبايا من الروم، وذلك نتيجة لترويج الإعلام الأموي، فقد رُوي أن هناك رجلاً شاميّاً كان في مجلس يزيد فسأله عن جارية، فقال يزيد: هذه فاطمة بنت الحسين، وتلك زينب بنت علي بن أبي طالب، فقال الشامي: الحسين بن فاطمة وعلي؟ قال يزيد: نعم، فأجاب الشامي: لعنك الله يا يزيد؛ تقتل عترة نبيك وتسبي ذريته! والله ما توهمت إلاّ أنّهم سبي روم([353]).
لذلك قامت السيّدة سكينة‘ بدور إعلامي منذ دخولها إلى الشام، لكي تزيل الوهم والستار عن الحقيقة، ولكي لا يتوهّم النّاس بأنّ هؤلاء سبايا روم، فعندما دخلت دمشق في النهار والنساء مكشّفات الوجوه، قال أهل الشام الحفاة: ما رأينا سبايا أحسن من هؤلاء، مَن أنتم؟ فقالت سكينة بنت الحسين: نحن سبايا آل محمد([354]).
وبهذا قامت السيّدة سكينة بدور إعلامي منذ دخولها الشام، وعرّفت عن نفسها ومَن معها بأنّهم سبايا آل محمّد؛ حتّى يعلم النّاس خطايا يزيد وأعوانه، وما اقترفوه من أخطاء بحقِّ الحسين× ونسائه، فأرادت أن تكشف زيف الدعاية الأموية التي كانت تدّعي بأنَّ هؤلاء السبايا من الخوارج، أو عصابة متمرِّدة على الدولة الأموية.
إنّ للدور الإعلامي تأثيرا كبيرا في تحقيق أهداف الثورة، والتغطية الإعلامية الشخصية مهمّة قد تضفي عليها المكانة والكثير فيما يتعلّق بقدراتها الإقناعية والتأثيرية ومواجهة الآخرين([355]).
فيُعدُّ الإعلام أحد أهمِّ المؤسَّسات التربوية في المجتمع، حيث يساهم في تشكيل الرأي العام أو توجيهه نحو مسار معيّن، ويساهم أيضاً في القضاء على الشائعات التي نجد لها صدى شعبيّاؤ واسعاً عند النّاس؛ لذلك كان الدور الإعلامي أحد أسباب حمل الحسين× النساء معهُ؛ إذ كان للإعلام النسوي أثر كبير في نشر وقائع الثورة والتعريف بشخوصها، واستطاع اقتحام مركز قوّة العدو، وإماطة اللثام عن الحقائق التي حاول النظام إخفاءها، من خلال حملة التشويه التي قام بها ضد شخوص الثورة والإعلام بأنّ هؤلاء سبايا الترك والديلم، وأنَّ الذي قُتل في كربلاء هو من الخوارج، ولولا هذا الدور العظيم لماتت الثورة وأهدافها كما مات الكثير من الأحداث المهمّة التي شهدها التاريخ، والتي يعود سبب موتها الأصلي إلى عدم وجود مَن يتولّى المسؤولية الإعلامية ([356]).
5ـ دور السيّدة سكينة في إحياء النهضة الحسينية
لم تذكر المصادر الكثير من التفاصيل حول دور السيّدة سكينة عند رجوعها إلى المدينة بعد واقعة الطف؛ وذلك لأنّ المصادر ركّزت على الواقع السياسي والحربي أكثر من أيِّ جانب آخر، إلاّ أنّ من الطبيعي أنّ السيّدة سكينة رأت الكثير من المصائب عند نزولها في كربلاء، ومنها معارضة الحر وإجبار أبيها على النزول، والقلّة في أصحاب أبيها وكثرة جيوش الأعداء، وتفرّق بعض مَن كان مع أبيها×، كما شاهدت اضطراب النساء وخوفهنَّ حين نزلن كربلاء، وعطش أهل بيتها عندما منعهم القوم من الماء، كما كانت ترى الإنكسار في وجه أبيها، وشاهدت أولاد عمّها وأخيها يبارزون ويُقتل الواحد منهم بعد الواحد، وشاهدت الحسين× وحيداً بلا ناصر ولا معين، وقد أحاط به الأعداء من كلِّ جانب ومكان، وكيف أتت جسد أبيها بلا رأس وألقت نفسها عليه، ورأت رأس أبيها على الرمح دامي الوجه خضيب الشيبة، وكيف هجم القوم على الخيام، ومناديهم ينادي أحرقوا بيوت الظالمين، وكيف أُحرقت الخيام وفرّت النساء والأطفال إلى البيداء، ورأت أباها جسداً ملقى على الأرض تسفي عليه الرياح، وكيف أركبوها النياق المهزولة، وترى أخاها السجاد مكبّلاً بالحبال، وهو من شدّة المرض لا يطيق الركوب، وقد قيّدوه من تحت بطن الناقة، وترى عمَّها وأولاد أخوتها، وترى جيش الأعداء يمرحون، والسياط بأيديهم يضربون بهاالأطفال فكانت تمزِّق أجسادهم([357]).
لم تنسَ السيّدة سكينة كلَّ هذه الأحداث بسهولة، بل على العكس، فقد رافقتها تلك الذكريات إلى وفاتها وخلّفت لها جرحاً عميقاً، وعند رجوعها إلى المدينة عملت على إحياء النهضة الحسينية وذلك عن طريق:
أ ـ الحزن وإعلان الحداد العام
لقد أُعلن الحزن والحداد منذ خروج السبايا من الشام، فقد ذُكر أنّ السيّدة زينب‘ عندما رأت المحامل مزيّنة جذبت في قلبها الحسرة، وقالت: ماذا نصنع بالمحامل المزيّنة، فأمروا بالمحامل وضربوا عليها السواد، وضجّ النّاس لهذا المنظر، وعلا بكاؤهم وعويلهم حزناً لمصاب أهل البيت^([358]).
فإعلان الحزن أثار حنق النّاس على سلطة يزيد، والتأنيب لكلّ مَن ساهم في هذه الجريمة، لذلك نرى الإمام السجاد× طلب من بشير بن جذلم([359]) أن ينعى الحسين× قبل دخول النساء إلى المدينة، فروى بشير قائلاً: فركبت فرسي وركضت حتّى دخلت المدينة، فلمّا بلغت مسجد النبي| رفعت صوتي بالبكاء وأنشأت أقول:
|
يا أهلَ يثربَ لا مُقامَ لكم بها |
فلم تبقَ في المدينة مخدَّرة ولا محجَّبة إلاّ برزت من خدرها، وهن بين باكية ونائحة ولاطمة، فلم يُرَ يوم أمرّ على أهل المدينة منه([361]).
كما روي أنّ الإمام السجاد بكى على أبيه أربعين سنة صائماً نهاره وقائماً ليله، فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه، فيضعه بين يديه ويقول: كُل يا مولاي، فيقول: قُتِل ابن رسول الله عطشاناً، فلا يزال يكرِّر ذلك ويبكي حتّى يبتلّ الطعام من دموعه، واستمر على هذا الحال حتّى لحق بالله عزّ وجلّ([362]).
كما حزنت الهاشميّات لمدّة خمس سنين، فقد روي عن الإمام الصادق× قال: «ما اكتحلت هاشمية ولا اختضبت، ولا رُؤي في دار هاشمي دخان خمس سنين حتّى قُتل عبيد الله بن زياد»([363]).
ورُوي عن السيّدة فاطمة بنت الحسين÷ أنّها قالت: «ما تحنّت امرأة منّا ولا أجالت في عينها مروداً، ولا امتشطت حتّى بعث المختار برأس عبيد الله زياد»([364]).
وقد روي عن زرارة ([365]) عن أبي عبد الله×: «ما اختضبت امرأة منّا ولا ادّهنت ولا اكتحلت ولا رجلّت حتّى أتانا رأس عبيد الله بن زياد، وما زلنا في عبرة من بعده»([366]).
من هنا يتّضح أنّ الحزن والحداد كان له أثر في قيام الثورات المعارضة للحكم الأموي، وكان نتيجة الحزن قطع رأس ابن زياد. ولابدّ من الإشارة إلى أنَّ السيّدة سكينة هي واحدة من الهاشميات ، حيث أعلنت الحداد والحزن مع بقية الهاشميات، وذلك لمّا أصاب أهلها، ولما تعرّضت له أثناء مرحلة السبي.
عاشت السيّدة سكينة في بيت الإمام السجاد الذي لم يزل ليله ونهاره باكي العين على سيد شباب أهل الجنّة، وكان جوابه لِمَن يطلب منه التخفيف لئلا تذهب عيناه: إنّي كلمّا نظرت إلى عماتي وأخواتي تذكرت فرارهنَّ من خيمة إلى خيمة، هكذا كان حزنه إلى أن استُشهِد، فكان عميد البيت لا يَفتر عن النياحة مدّة حياته، فما ظنّك بمَن حواه البيت من نساء ومَن شأنهنّ الرقّة والجزع. السيّدة سكينة تأوي هذا البيت المفعم بالحزن والشجن، وفي مسامعها نشيج أخيها الحجّة، وتبصر تساقط دموعه على خدّيه، لا تبارح ذاكرتها الهياكل المضرَّجة بالدماء، وقد شاهدتهم صرعى مقطّعي الأوصال([367]).
ب ـ رواية أحاديث عن واقعة الطف
لقد كانت السيّدة سكينة أكثر واحدة من النساء اطّلعت على أحوال المعركة؛ وذلك لكونها واقفة على باب الخيمة منتظرة الماء، كما أنّها خرجت بعد مقتل الحسين× ورأت ما صُنع بأبيها، ورأت القتلى متناثرين، فكانت السيّدة سكينة والسيّدة فاطمة بنت الحسين^ أكثر النساء تحمّلاً للمسؤولية؛ وذلك لكون السيّدة أمِّ كلثوم تُوفيّت بعد الرجوع إلى المدينة بوقت قصير، والسيّدة زينب تُوفيت سنة 62هـ/181م([368])، فبقى الحمل الأكبر على السيّدة سكينة وفاطمة÷، لكونهما عُمِّرتا لوقت طويل.
لقد أخذت السيّدة سكينة على إذكاء نار النهضة الحسينية عن طريق روايتها لأحداث واقعة الطف، وكيفية قتل الحسين×؛ إذ حُجِب كلُّ ما جرى في كربلاء إزاء التضليل الإعلامي، وتزييف الحقائق والوقائع الذي اعتمدته السياسة الأموية . يذكر السيد الصدر: أنَّ رواة واقعة الطّف هم الأئمة المعصومون^ المتأخرون عن الحسين×، وخاصّة الثلاثة الذين كانوا بعده بالمباشرة، وهم الإمام السجاد، والإمام الباقر، والإمام الصادق^، والنساء من ذراري الحسين× وأصحابه من بعد عودتهنَّ إلى المدينة المنوّرة، فإنهنَّ لم يُصبْنَ بسوء، وبقين أحياء بعد مقتل رجالهنَّ، ورجعنَ إلى محلِّ سكناهنَّ، وتُعدُّ كلُّ واحدة منهنَّ شاهد حال حاضراً في الواقعة([369]).
لقد استمرّت السيّدة سكينة طوال هذه الفترة حتّى وفاتها تروي أحداث واقعة الطف، وكلَّ ما صادفته، وذلك لكي تبقى مأساة كربلاء خالدة في أذهان النّاس عبر التاريخ، فكان لمرويّاتها دور كبير في إذكاء نار الثورة ضدَّ الحكم الأموي، فقد استمرّت الثورات ضدَّ الحكم الأموي([370]).
لم تذكر المصادر الكثير من الروايات سوى التي أشرنا إليها سابقاً، ولربّما كان ذلك بسبب تركيز المصادر على الأحداث السياسية أكثر من أيِّ جانب آخر، فمن روايات السيّدة سكينة أنَّها قالت: لمّا خرجنا من المدينة ما كان أحد أشدَّ خوفاً من أهل البيت([371]).
وهذه الرواية توضّح مدى صعوبة تركهم مدينة رسول الله|، كما روت حال الحسين× ليلة العاشر عندما تفرّق عنه بعض مَن جاء معه.
ففي اليوم الثاني من محرم نزل الإمام الحسين× كربلاء ونُصبت الخيام([372]) واستعدَّ× لهجوم الجيوش الأموية، فلمّا كان اليوم الثاني لنزوله كربلاء وافاه عمر بن سعد في أربعة آلاف فارس([373]).
وروت كيف اعتنقت جسد أبيها وهو يقول: «شيعتي ما إن شربتم ريَّ عذب فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني»([374]).
وشاهدت كيف يضرب يزيد شفاه الحسين× حيث قالت: «والله ما رأيت أقسى قلباً من يزيد، ولا رأيت كافراً ولا مشركاً شرّاً منه»([375]).
هكذا لم تنسَ السيّدة سكينة الأحداث، وأخذت تروي ما رأته، فقد كانت على قدر المسؤولية التي حمّلها إيّاها الحسين×، حيث كانت تحمل رسالة ناطقة عبر الزمان الذي عاشته، ونستطيع أن نقول: عاشت السيّدة نهضةَ الحسين× إلى وفاتها.
6ـ دور السيّدة سكينة في الجانب الثقافي والفكري
لقد اتّسمت مدرسة أهل البيت الفكرية والعلمية بخصائص رفيعة، إلى حدٍّ جعلها ترتفع على جميع المداس الإلهية، فكان مركز هذه المدرسة النبي الأكرم| وأهل بيته، ومن هنا اكتسبت السيّدة سكينة منابع الري الصافية، فكان لها عطاء في الجانب الثقافي، ولكنَّ هذا الجانب لم يظهر بشكل واضح؛ بسبب السياسة الظالمة التي انتهجتها السلطات الأموية الحاكمة، فكان التعتيم هو السائد في حياة الأمويين، وهذا التعتيم لا يشمل الرجال فقط، بل تعدّاه إلى النساء أيضاً([376]).
لقد أشعل الأمويون حرباً أشدّ وأقسى من السيف منذ نشأة الدولة على يد معاوية، حيث قال للعمّال: «لا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب، إلاّ وأتوني بمناقض له...»([377]).
لم يقف الأمويون عند هذا الحدِّ، بل تمادوا في التضليل وإنكار منجزات وفضائل آل البيت، وكلام معاوية أعلاه خير دليل على التزوير والغش، وتشويه الحقائق، وافتعال الأقاويل.
فحاولوا أن يعطوا من خلال ذلك صورة مشوّهة عن أهل البيت^، وهذا ما استدعى المواجهة؛ ليُعاد الوضع إلى نصابه، فكانت كربلاء هي آخر صورة من صور الصدام المسلح بين الإسلام النبوي والإسلام الأموي([378])، ومن خلال ذلك نقول: إنّ مدرسة آل البيت الفكرية بكلِّ معطياتها لها جذور ممتدّة في عمق التاريخ الإسلامي، وإنّ السياسة الأموية ومقتضياتها أرادت أن تُعتّم على تلك المدرسة الفكرية، وتجعل جهود روّادها الأوائل في مهبِّ الريح، وهكذا حاولت تضليل الجانب الفكري والثقافي للسيّدة سكينة، وأرادت أن تطمس جهودها كعلوية لمجتمع المدينة بعد وفاة السيّدة زينب‘.
وكلُّ مَن أراد أن يتمعّن في هذا الوقت يجد فجوة علمية وثقافية وفكرية من بعد وفاة السيّدة زينب‘، ولكن منَ سيَسدُّ تلك الفجوة ؟ وهل ستترك تلك الجهود سدى؟ لقد كانت السيّدة سكينة‘ خير مَن قام بذلك الجهد ومثّلته خير تمثيل.
فقد كانت دار السيّدة سكينة مركز إشعاع للمعرفة والفكر، وكان لها دور نشر المعرفة في جميع أوساط المجتمع؛ حتّى لا يُحرم أحد من حقّه في الثقافة والوعي، واكتسبت هذا العهد من مدرسة كانت تفسِّر القرآن وتروي الأحاديث([379]).
وبعد وفاة السيّدة زينب‘ أخذت السيّدة سكينة تعقد المجالس الدينية، فقد كانت سكينة سيّدة نساء عصرها، وأوفرهنَّ ذكاءً وعقلاً وأدباً وعفّة ومعرفة، وكانت تُزيِّن مجالس نساء أهل المدينة بعلمها وأدبها وتقواها، وكان منزلها مدرسة لتعليم الفقه والحديث([380])، ودليل ذلك رواياتها ـ على الرغم من قلّتها إلاّ أنَّ هذا لا يعني أنها لم تروِـ فقد روت أحداث واقعة الطفّ ـ كما ذكرنا سابقا ـ وأحاديث عن النبي’.
ذكرت المصادر أنَّ السيّدة سكينة رَوت عن أبيها، وروى عنها فائدة المدني([381])، وذكر ابن حبان: «... تروي عن أهل بيتها، وروى عنها أهل الكوفة»([382])، غير أنّه لم تذكر تلك المصادر تلك الروايات، ولم أعثر على الكثير من الروايات باستثناء بعضها، فقد رَوت عن أبيها× عن رسول الله| أنّه قال: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنّة يوم القيامة»([383]).
كما روت‘ عن أبيها الحسين× عن الرسول| قال: «ولدي الحسين يُقتل بأرض كربلاء غريباً وحيداً عطشاناً فريداً، فمَن نصره فقد نصرني ونصر ولده القائم، ولو نصرنا بلسانه فهو في حزبنا يوم القيامة»([384]).
وكذلك رَوَت عن أمِّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب^، عن فاطمة بنت رسول الله|، قالت: «سمعت رسول الله| يقول: لما أُسري بي إلى السماء دخلت الجنّة فإذا أنا بقصر من درّة بيضاء مجوّفة، وعليها باب مكلّل بالدرّ والياقوت، على الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله علي ولي القوم، وإذا مكتوب على الستر بخ بخ من مثل شيعة علي؟ فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مجوّف، وعليه باب من فضة مكلّل بالزبرجد الأخضر، وإذا على الباب ستر، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب محمّد رسول الله ، علي وصيُّ المصطفى، وإذا على الستر مكتوب: بشِّر شيعة علي بطيب المولد، فدخلته فإذا أنا بقصر من زمرد أخضر مجوّف لم أرَ أحسن منه، وعليه باب من ياقوته حمراء مكلّلة باللؤلؤ، وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الستر شيعة علي هم الفائزون، فقلت: حبيبي جبرائيل لِمَن هذا؟ قال: يا محمّد لابن عمّك علي بن أبي طالب، يُحشر النّاس كلّهم يوم القيامة حفاة عراة إلاّ شيعة علي، ويُدعى النّاس بأسماء أمهاتهم ما خلا شيعة علي؛ فإنّهم يُدعون بأسماء آبائهم، فقلت: حبيبي جبرائيل وكيف ذلك؟ قال: لأنّهم أحبّوا علياً فطاب مولدهم»([385]).
ورَوَت السيّدة سكينة عن أمِّ كلثوم، عن فاطمة، عن النبي| قالت: «أنسيتم قول رسول الله| يوم غدير خُمٍّ مَن كنت مولاه فعليّ مولاه، وقوله|: أنت منّي بمنزلة هارون من موسى»([386]).
الفصل الثالث
الشُّبُهات التي وردت حول السيّدة سكينة‘
تمهيد
أولاً: شبهة زيجات السيّدة سكينة‘
عاشت السيّدة سكينة‘ حياتها في المدينة بعد الرجوع من الشام، فهي لم تفارق المدينة منذ عودتها إليها بعد واقعة الطف، بل ولم تتخلّف عن بيت أخيها الإمام السجّاد×، الذي كان دائم البكاء والحزن حتّى وفاته94هـ/712م([387])، وبعد الإمام السجاد× عاشت في بيت الإمام الباقر×94ـ117هـ/712ـ735م، فهي امرأة وحيدة تحتاج إلى من يكفلها خاصّة مع انقطاعها إلى العبادة، فمن الناحية النفسية فإنَّ كلَّ ما مرّت به السيّدة سكينة بقى عالقاً في ذهنها؛ وذلك لأنَّ كلّ ما حدث في الماضي لا ينقطع بمجرد انتهائه، بل يظلّ قائماً بملابساته السابقة، وهكذا فإنّ كلَّ ما مرّت به السيّدة لابدّ وأن يترك أثراً في شعورها([388]).
إلا أنّ الكتابات التاريخية تبقى محبوسة الأنفاس بين ما احتكره أهل الصنعة من التزوير، وبين ما استحسنه الحكّام من كتابة بما ينسجم وتطلّعاتهم في إلغاء مسلّمات الواقع، أو فرض تخيّلات القصّاصين على كلِّ أهل التاريخ، وإذا أردنا أن نحسن الظنَّ بما سطّر هؤلاء، فتبقى المرويات التاريخية معتمَة، لا يحقُّ لها أن تتفوّه عمّا أضافته يد الوضع عليها، أو تلك النابعة من تخيّلات القصّاصين؛ مجاراة للوضع السياسي القائم أو لنزعات تكتُّل معيَّن، أو تنفيذا لرغبة نفسية جامحة، أو استجابة لمصالح شخصية وطموحات سياسية هائجة، تسحقُ معها كلّ مبدأ، وتقلِّل من خلالها كلّ فضيلة، وتوأد بسببها كلّ مكرمة، وليس في منطق هؤلاء غير رضا أسيادهم، وإشباع حاجات أوليائهم عن طريق الوضع.
وبين أيدينا نموذج ممّا جنته الأهواء في كتابة التاريخ، وما فرضته المصالح من التزوير، وما أفرزته صراعات التكتلات السياسية من تضليل، وكان نصيب هؤلاء من تخيّلاتهم في مروياتهم، وطعنهم بأهل البيت^، أن صوروا السيّدة سكينة‘ أنّها من أهل اللهو، فهي تتعاطى الغناء كما تتعاطى التحكيم بين الشعراء والمغنين، وتتزوّج من الأمويين والزبيريين دون مانع، وكأنّها موقوفة بين آل مروان وآل الزبير، فبين مفارق لها وبين كاره، وبين خاطب وبين مطلّق، وكأن لم يكن من بني هاشم أكفاء يتولون أمرها، أو وليّ يحسن منعها عمّا ترتكبه ممّا يخالف الدين وينافي العرف([389]).
فعند الوقوف أمام السرد التاريخي المغرض الذي تناول زواج السيّدة الجليلة‘ نراه قد كُتِب بأقلام باغضة لأهل البيت^، وحاسدة لعلوِّهم، وباكية على البيت الأموي الذي ملأ الدّنيا عيوباً وانحرافاً وفساداً، ومَن يقرأ التاريخ المنحرف لا يرى إلاّ مكاره تندهش لها العقول، فإنَّ الحقد الأموي ألصق التهم بأشرف أسرة في الوجود، وبالحقيقة هذه التهم لا تليق إلاّ بآل أميّة وآل مروان وآل زياد، وبمَن سار على نهجهم وتلبّس بأخلاقهم.
هكذا اتّهم المؤرِّخون السيّدة سكينة بأنّها تزوّجت من خمسة أزواج، وذلك بدواع واهية، وبطريقة لا تليق إلاّ بامرأة لا حياء لها ـ حاشاها من ذلك ـ ولا وليّ لها يمنعها، ولا عشيرة تغار عليها.
وهذا ليس أوّل تشويه، فقد كان رواة الأخبار ووضّاع الأحاديث أخطر الآفات على العلم، فقد شوّهوا تراجم مشاهير، لدرجة وُضِعت الأحاديث حتّى لا تكاد تميّز بين الصحيح منها والموضوع، وتبدأ مرحلة الوضع سنة 41هـ/661م؛ فإعلان معاوية بن أبي سفيان تمرّده على الخلافة وإعلان استقلاليته وخروجه عن السلطة المركزية، ففي عهد الإمام علي بن ابي طالب÷ صارت محاولة لتطهير ثقافي وترشيد فكري بكلِّ ما لهذا المصطلح من معنى وسيع عميق([390]).
فإنَّ كلّ رواية ضعيفة وموضوعة لا تصلح أن تكون مادّة فكرية تاريخية ولا يمكن الإستدلال بها، وإنّ سبب هذه الروايات هو دافع سياسي، الغرض منها إرضاء الخلفاء الذين ينقمون من آل علي بن أبي طالب([391]).
فاستخدام الأمويين شتّى الأساليب لدوافع سياسية، حيث استخدموا الإعلام المضادَّ الذي يهدف إلى خداع النّاس وتضليلهم وتشويه الشخصيات الفاضلة، وخاصة أهل بيت النبي وذريتهم، وكان الغرض من ذلك تحويل أنظار الأمّة بعيداً عنهم وإقصاءهم عن دورهم الشرعي والسياسي والإجتماعي؛ تمهيداً لاستلام السلطة وتحقيق أمنية أبي سفيان: «مازلت أرجوها لكم وتصيرنّ إلى صبيانكم وراثة...»([392]).
كما أنّ التأريخ مرّ بمرحلة تزوير، يقول السيد الصدر: «إنّ الدسّ المتعمّد الذي كان مدعوماً من قبل الدولة في القرون الأولى كان كثيراً، فكان هناك مجموعة من القصّاصين يروون الروايات مقابل الأموال...، فقد سُبَّ الإمام علي بن أبي طالب÷، وشُتِم على المنابر سنين طويلة، فليس من العجب أن يهتكوا ابنه أو ابنته...»([393]).
ويعتبرمصعب بن عبد الله الزبيري(ت236هـ ـ 851م) صاحب كتاب نسب قريش، واحدا من تلك النماذج التي شوّهت سيرة بنت رسول|، بل هو أوّل مَن وضع تلك الشبهات، ولو ألقينا نظرة سريعة على سيرة مصعب الزبيري لوجدنا تاريخ أسرته مليئاً بالحقد، كما أنّ أغلب كتب الرجال ضعّفته، وسنقدِّم استعراضاً لتلك الكتب:
ذكر ابن سعد: «كثير الحديث ضعيف»([394]).
وقال العقيلي: «حدثنا عبد الله بن أ حمد بن حنبل قال: سألت أبي عن مصعب بن ثابت، فقال أراه ضعيف الحديث»([395]).
أما ابن عدي فيقول: «سألت يحيى بن معين عن مصعب بن ثابت كيف؟قال: ضعيف»([396]).
ويذكر ابن النديم: «كان راوية أديباً محدثاً، وهو عمُّ الزبير بن بكار، وكان أبوه عبد الله من شرار النّاس، متحاملاً على ولد علي...»([397]).
وذكر ابن الجوزي: «قال يحيى: ضعيف، وقال مرّة: ليس بشيء، وقال أحمد: أراه ضعيف الحديث، وقال السعدي: لم أرَ النّاس يتحدثون عنه، وقال الرازي: لا يُحتجُّ به، وقال ابن حبان: انفراد ه بالمناكير عن المشاهير...»([398]).
ويشير ابن الأثير: «كان عالماً فقيهاً، إلاّ أنّه كان منحرفاً عن علي»([399]).
وذُكِر من بين الضعفاء عند الذهبي([400])، وقال ابن معين ضعيف، ومرّة قال: ليس بشيء، وقال أحمد أراه ضعيف الحديث، وقال السعدي: لم أرَ النّاس يتحدّثون عنه([401]).
أمّا ابن حجر العسقلاني فيقول: «قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: أراه ضعيف الحديث، لم أرَ النّاس يحمدون حديثه، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ضعيف. قال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي: مصعب ليس بالمقرئ في الحديث، وقال ابن حبان في الضعفاء: تفرّد بالمناكير عن المشاهير، فلمّا كثُر ذلك فيه استحقّ مجانبة حديثه...»([402]).
أمّا النموذج الثاني فهو الزبير بن بكار (ت256هـ ـ 870م)، صاحب كتاب جمهرة نسب قريش وأخبارها، وهو ابن أخي مصعب بن عبد الله بن الزبير الذي تكلمنا عنه، بل وتلميذه الذي أخذ عنه النسب([403])، وهذا بحد ذاته مضعف لما ينقله الزبير بن بكار. وكذا يقول ابن حجر العسقلاني عنه: «قال ابن أبي حاتم رأيته ولم أكتب عنه...، وقال أحمد بن علي السليماني... كان منكر الحديث...»([404]).
كان أبو بكار ظلم الإمام الرضا× ([405]) في شيء فدعا عليه، فسقط عليه ـ في وقت دعائه عليه ـ حجر من قصره، فاندقّت عنقه فمات([406]).
يقول المرزباني: «تحامل الزبير بن بكار على كُثَيْر ـ فيما جمعه من أخباره، وبيّن عليه من سرقاته ـ ظاهر، وهو خصم لا يُقبل قوله على كُثَير؛ لهجاء كُثير لولد عبد الله بن الزبير وانحراف الزبير عن أهل البيت^»([407]).
وابن عبد ربّه الأندلسي (ت328هـ ـ 939م)، صاحب كتاب العقد الفريد، وهو نموذج آخر عمل على سبِّ الإمام علي×، ووضع الشبهات على السيّدة سكينة‘.
كان ابن عبد ربّه مولى أمير الأندلس هشام بن الداخل الأندلسي([408])، ويقول ابن بسّام عنه: «وأمّا ابن عبد ربّه القرطبي... مدائحه مروانية... وطاعن مداعس»([409]).
نظم أرجوزة يذكر فيها الخلفاء، جعل معاوية بن أبي سفيان رابعهم، ولم يذكر الإمام علياً×([410]).
كان يميل إلى بني أميّة، عاملاً على الطعن في أهل البيت^.
وأبو الفرج الأصفهاني (ت356هـ ـ967م) الذي حمل الإساءة إلى أهل البيت^ في كتابه الأغاني، الذي طفح بالأخبار التي تسيء إلى السيّدة سكينة، وتجرح سيرتها، وتقدح في سلوكها.
يرجع أبو الفرج الأصفهاني في نسبه إلى مروان الحمار، آخر خلفاء الدولة الأموية، صنف الكثير من الكتب لبني أميّة في الأندلس([411]).
أمّا آراء الرجال فيه فهي: يقول الخطيب البغدادي: «إنَّ أبا محمّد الحسن بن الحسين× النوبختي كان يقول: كان أبو الفرج الأصفهاني أكذب النّاس، كان يشتري شيئاً كثيراً من الصحف، ثمّ يكوِّن كلَّ رواياته منها»([412]).
وقال ابن الجوزي عنه: «ومثله لا يُوثَق بروايته، يصرِّح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهوِّن شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومَن تأمّل كتاب الأغاني رأى كلَّ قبيح ومنكر»([413]).
كما قيل عنه: «كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار، وأيام النّاس، والشعر والغناء والمحاضرات، يأتي بأعاجيب...»([414]).
وكان من أصحاب الوزير أبي محمّد المهلبي([415])..
وذكر عنه البعض بأنّه كان وسخاً في نفسه وفي ثوبه، قذراً لم يكن يغسل درّاعة يلبسها ولا تزال عليه إلى أن تبلى([416]).
اعتمد أبو الفرج الأصفهاني في كثير من أخباره السوداء المظلمة على طائفة من الرواة الكذّابين والمجروحين والمطعون فيهم، واعتبر أخبارهم موثّقة.([417]).
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا انفرد أبو الفرج الأصفهاني بكثير من الأخبار عن السيّدة سكينة من دون بقية المؤلِّفين؟ على الرغم من أنّ أبا الفرج لديه كتاب مقاتل الطالبيين ذكر فيه شهداء من ذرية أبي طالب، مقتصراً فيه على كلِّ مَن كان نقيّ السيرة قويم المذهب، مُعرِضاً عن ذكر مَن عدل عن سنن آبائه وحاد عن مذهب أسلافه، وكان مصرعه في سبيل أطماعه، وجزاء ما اجترحت يداه من عبث وإفساد([418]).
وعلى الرغم من انتساب أبي الفرج إلى بني أميّة، فإنه ـ على رأيٍ ـ كان متشيعاً، وكان متقصداً في تشيعه؛ لهذا فهو لم ينكرعلى الحكّام الأمويين في الأندلس، بل ظلّ يرسل إليهم كتبه وينال على ذلك العطايا المجزية ([419]).
وعلى رواية أنَّ أبا الفرج الأصفهاني حمل كتاب الأغاني إلى سيف الدولة بن حمدان([420]) فأعطاه ألف دينار واعتذار، وحُكي عن الصاحب بن عباد أنّه كان في أسفاره وتنقلاته يستصحب حمل ثلاثين جملاً من كتب الأدب؛ ليطالعها، فلمّا وصل إليه كتاب الأغاني لم يكن بعد ذلك يستصحب سواه ([421]).
يرى الحلو: أنَّ هذا الكتاب الذي قدَّمه أبو الفرج إلى أمير الحمدانيين غير كتاب الأغاني الذي بين أيدينا، بل هو كتاب إمّا منسوب لأبي الفرج الأصفهاني أو محرَّف طالته يد الوضع والتحريف([422]).
وعلى أيّة حال ـ سواء كان كتاب الأغاني لأبي الفرج أم لا ـ فإنَّ الأساليب الأموية عملت على حركة التزوير في التاريخ، وغيّرت لما فيه مصلحتهم؛ محاولة منهم لطمس فضائل أهل البيت^.
اولاً: شبهة تعدّد زواج وطلاق السيّدة سكينة‘
إنّ الزواج سنّة الله تعالى ورسوله|، ولا يوجد أيُّ منقصة على المرأة الأرملة أو المطلّقة من ممارسته؛ لأنّه حقٌّ من حقوقها، وهو غير مخالف للشريعة المقدّسة، فلا نجد ضرورة لإنكاره، ولكن يكون مثاراً للتساؤل والإستنكار حينما يُقصد منه الطعن بأهل بيت النبوّة، وحينما ترمي بريئة بأكذوبة تعدّد الأزواج، وتُتّهم بأنّها تتزوّج من أعداء أهل البيت، ممّن يسبُّ الإمام علياً في اليوم خمس مرات على منبر رسول الله|([423])، أو من دونهم في الشرف والمنزلة، ما بين زبيري ومرواني وأموي.
وفي الوقت نفسه تُغيِّب فيه الروايات دورَ الأئمة، ويكون حكّام بني مروان هم ولاة أمر بنات النبوّة، فمثل هكذا زواج يكون مثاراً للشكّ والإستنكار، ويكون القصد منه التغطية على ارتكاب الجرائم والفواحش باسم الدين.
يُعاب على المؤرِّخين المسلمين اقتصارهم في التواريخ أو التراجم على إيراد الحوادث على حالها كما بلغتهم ـ وقد تكون مسندة إلى راوٍ أو عدة رواة ـ بلا نقد ولا تمحيص ولا قياس مكتفين بالإسناد، وقد فاتهم أنّ بعض الأخبار مسندة لأغراض سياسية ([424]).
وكلّ مَن يتصفّح كتب التاريخ والأدب يجد أنّ سكينة بنت الحسين÷ تزوّجت من عدّة رجال، وهذه الشبهة أصبحت من المسلَّم بها عند بعض المؤرِّخين، فقد بلغ عدد الزواج في بعض الروايات ست مرّات، وتقلّ في روايات أخرى، وقد نجد اختلافاً واضحاً حول ترتيب الزواج، كما يوجد تناقض واضح جداً في أولئك الأزواج، وسنستعرض تلك الروايات ثمّ نناقشها تفصيلياً.
ذكر ابن سعد: «تزوّجت مصعب بن الزبير بن
العوام ، أبتكرها فولدت له فاطمة، ثمّ قُتل عنها، فخلف عليها عبد الله بن عثمان بن
عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد
ابن أسد([425])... فولدت له قريناً وحكيماً
وربيحة فهلك عنها، فخلف عليها زيد بن عمرو
ابن عثمان بن عفان([426]) فهلك عنها، فخلف عليها إبراهيم
بن عبد الرحمن بن عوف الزهري([427])، كانت ولّته نفسها، فتزوَّجها
فأقامت معه ثلاثة أشهر، فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه بالمدينة أن يفرِّق بينهما
ففرَّق بينهما، وقال بعض أهل العلم: هلك عنها زيد ابن عمرو بن
عثمان، وتزوَّجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان»([428]).
ومن هنا يزعم ابن سعد أنّ السيّدة سكينة‘ تزوّجت من أربعة أزواج مع اختلاف في الشخص الرابع، أمّا الزبيري فيقول: «كانت سكينة بنت الحسين عند مصعب بن الزبير، ثمّ خلف عليها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد، فولدت له حكيماً وعثمان ، وهو قرين وربيحة، تزوّج ربيحة العبّاس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، ثمّ خلف على سكينة زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثمّ خلف عليها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلم يتمَّ نكاحه، فرَّق بينهما هشام بن عبدالملك، ثمّ خلف عليها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، فحُملت إليه بمصر، فوجدته قد مات»([429]).
يزعم صاحب هذه الرواية أنّ السيّدة سكينة تزوّجت من خمسة رجال، الرابع منهم لم يتمّ بسبب هشام بن عبد الملك، أمّا ابن حبيب فيقول: «تزوّجت سكينة بنت الحسين بن علي بنِ أبي طالبٍ عبدَ الله بنَ الحسن بنِ علي، وكان أبا عذرتها، فمات عنها، فخلّف عليها مصعب بن الزبير، فولدت له فاطمة، فماتت وهي صغيرة، فقُتل عنها، فخطبها عبدالملك بن مروان فأبته، فتزوّجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم... ثمّ الأصبغ ابن عبد العزيز بن مروان فلم يصل إليها فارقها قبل ذلك، ثمّ زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثمّ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فلم يدخل بها، وخُيّرت فاختارت نفسها»([430]).
فهذه الرواية فيها أربعة أزواج للسيّدة سكينة، وثلاثة خطبوها ولم يتمّ الزواج، أمّا الزبير بن بكار فيذكر أنّ السيّدة سكينة لم تتزوّج إلاّ رجلاً واحداً وهو مصعب بن الزبير([431]).
و بعض المصادر تذكر: تزوّجها مصعب بن الزبير فهلك عنها، ثمّ تزوّجها عبد الله بن عثمان بن عبدالله بن حكيم فولدت له قريناً، ثمّ تزوّجها الأصبغ بن عبد العزيز ابن مروان وفارقها قبل الدخول، ثمّ تزوّجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفّان، فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها ففعل([432]).
أمّا أبو الفرج الأصفهاني فيقول: «تزوّجت سكينة بنت الحسين عدّة أزواج، أولهم عبد الله بن الحسن بن علي وهو ابن عمّها وأبو عذرتها، ومصعب بن الزبير، وعبدالله بن عثمان الحزامي، وزيد بن عمرو بن عثمان، والأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ولم يدخل بها، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ولم يدخل بها»([433]).
كما يذكر: أنّ سكينة عند عمرو بن حكيم بن حزام، ثمّ تزوّجها بعده زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثمّ تزوّجها مصعب بن الزبير، فلمّا قُتل مصعب خطبها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف([434]).
فنلاحظ وجود اضطراب كبير في رواية أبي الفرج الأصفهاني؛ يزعم أنّها تزوّجت من أربعة أزواج، واثنان لم يتمّ الزواج منهما، كما يضيف رجلاً آخر وهوعمرو بن حكيم.
أمّا سبط بن الجوزي فيقول: «وأمّا سكينة فتزوّجها مصعب بن الزبير فهلك عنها، فتزوّجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام فولدت له عثمان الذي يقال له قرين، ثمّ تزوّجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان أخو عمر بن عبد العزيز ثمّ فارقها قبل الدخول بها»([435]).
إنَّ الغرض من عرضنا الروايات التاريخية؛ لتوضيح اضطراب الروايات واختلافها، وهذا ما يجعلنا نشكُّ في مصداقيتها، مع الأخذ بنظر الإعتبار أنّ معظم المصادر أموية ورواتها غير ثقات([436])، كما أنّ واضعي هذه الروايات وقعوا في شرِّ أعمالهم، فعندما كتبوا عن السيّدة ما لا يليق بها أرادوا أن يشوِّهوا سمعتها إلاّ أنَّهم ـ على العكس ـ أعطوا دليلاً على كيدهم؛ لذلك سنتقبل المقبول من الروايات، ونرفض ما يستحقّ الرفض، مناقشين روايات الزواج من بداية زواجها من مصعب بن الزبير، وسنحاول عرض كلِّ ما يتعلّق بزواجها منه.
1ـ شبهة الزواج من مصعب بن الزبير
لقد اتفقت أغلب المصادر على أنّ السيّدة سكينة تزوّجت مصعب بن الزبير، على الرغم من الإختلاف في ترتيبه بين الأزواج، فقد ذكرت المصادر أنّ مصعب بن الزبير كان يتمنّى الزواج من السيّدة سكينة قبل أن يكون أميراً على العراق، روى سفيان الثوري عن طارق بن عبد العزيز، عن الشعبي قال: لقد رأيت عجباً، كنّا بفناء الكعبة أنا وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومصعب بن الزبير، وعبد الملك بن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم: ليقم كلُّ رجل منكم فليأخذ بالركن اليماني، ويسأل الله حاجته؛ فإنّه يُعطي من ساعته، فقالوا قُم يا عبد الله بن الزبير فإنك أوّل مولود ولد في الهجرة، فقام فأخذ بالركن اليماني ثمّ قال: اللهمَّ إنّك عظيم تُرجَى لكلِّ عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك... حتّى توليني الحجاز ويُسلَّم عليّ بالخلافة وجاء حتّى جلس، فقالوا: قُم يا مصعب بن الزبير، فقام فأخذ بالركن اليماني فقال: اللهمَّ إنَّك ربُّ كلِّ شيءٍ وإليك يصير كلُّ شيء أسألك بقدرتك على كلِّ شيء أن لا تميتني من الدّنيا حتّى توليني العراق، وتزوّجني سكينة بنت الحسين... إلى نهاية الرواية. يقول الشعبي: فما ذهبت عيناي من الدّنيا حتّى رأيت كلَّ رجل منهم قد أُعطِي ما سأل([437]).
وفي رواية أخرى رواها عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجرة أربعة: مصعب وعروة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، فقالوا: تمنّوا، فقال مصعب: أمّا أنا فأتمنّى إمرة العراق، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين([438]).
فنلاحظ اختلافاً واضحاً في الروايتين؛ ففي الرواية الأولى كان المتمنِّين في فناء الكعبة ومعهم عبد الملك، وكانت أمنية مصعب إمرة العراق، والزواج من سكينة، وأمّا الرواية الثانية نجد عروة بن الزبير يحلُّ محلَّ عبد الملك، وكانوا في حجرة مصعب، وكانت أمنيته إمرة العراق والزواج من عائشة وسكينة.
كما يذكر ابن الأثير في أحداث سنة 67هـ/686م أنّ مصعباً لقي ابن عمر فسلّم عليه وقال له: أنا ابن أخيك مصعب، فقال له ابن عمر: أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة غير ما بدا لك، فقال مصعب: إنّهم كانوا كفرة فجرة([439]).
وهذا دليل على أنّ ابن عمر لم يعرف مصعباً في سنة 67هـ، فكيف التقوا في فناء الكعبة قبل هذا التاريخ؟!
كما لا ننسى أنّ الرواة كانوا أمويين، وقد ضُعِّفوا من قبل رجال الجرح والتعديل، فسفيان الثوري (ت126هـ/743م)([440]) اشتهر بالتدليس([441])، ويقول عنه الحلي: «ليس من أصحابنا»([442]).
وأمّا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد (ت174هـ/790م) فهو كثير الحديث، وكان ضعيفاً لروايته عن أبيه، ولا يُحتَجُّ بحديثه([443]).
أمّا الشعبي فهو أنموذج من نماذج العداء والبغض للإمام علي×، فكان لا يروي عن علي بن أبي طالب‘، على الرغم من روايته وحفظه، واعترف بذلك ابن حجر العسقلاني: «لم يسمع الشعبي من علي حرفاً واحداً ما سمع من غيره»([444]).
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أوغل في عدائه لعلي×، بحجة أنَّ الشيعة كانوا السبب في تجنبه مروياته عنه× فقال: لقد بغّضوا إلينا حديث علي بن أبي طالب([445]).
وإذا كان هذا حال الرواة فكيف يتمُّ لنا قبول مروياتهم، ولاسيما التي تتعلّق بالسيّدة سكينة‘؟
كما أنّ الروايات تدلُّ على أنّ مصعباً كان يرى سكينة سنة 69هـ/688م، وهي السنة التي تولّى فيها إمرة العراق([446])، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا أين رأى مصعب السيد سكينة ؟ ترى بنت الشاطئ أنّ تعلّق مصعب بالسيّدة سكينة أيام ظهرت في المجتمع المكي لأوّل مرّة، عندما اصطحبها أبوها× في رحلته إثر ولاية يزيد بن معاوية، وإلحاحه على واليه بالمدينة أن يأخذ البيعة من الحسين× قسراً([447]).
ترى الباحثة أنَّ هذا الكلام غير منطقي؛ هل يُعقل أن تخرج نساء الحسين× ومجتمع المدينة يتفرّج عليهنّ لدرجة يتعلّق بها مصعب، كما أنّ من سنة 61 ـ 69هـ/680ـ688م لم تُشفَ السيّدة بعدُ من الجروح التي خلَّفتها وحشية الأمويين، كما أنّها انشغلت بالعبادة والحزن، وإحياء النهضة الحسينية إلى جنب أهلها.
كما يذكر أبو الفرج الأصفهاني: «كتب أنس بن زنيم الليثي([448]) إلى عبد الله بن الزبير:
|
أبلغ أميرَ المؤمنين رسالة |
فعبّر في هذه الأبيات بأنّ مصعباً تزوّج بامرأتين بألفي ألف درهم، وعلى أثر هذا عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعباً من البصرة، وعيّن ابن حمزة مكانه؛ بينما يذكر ابن قتيبة الدينوري نفس الرواية وأنَّها قِيلت بحقِّ عائشة بنت طلحة([450]).
ويذكر أبو الفرج الأصفهاني أيضا أنّ زواج سكينة من مصعب تمَّ عن طريق الإمام زين العابدين، فأمهرها مصعب ألف ألف درهم، وروي أنَّ علي بن الحسين× أخاها حملها إليه، فأعطاه أربعين ألف دينار([451])، وهذا يعني أنّ مهر السيّدة ألف ألف دينار، وأعطى مصعب زين العابدين أربعين ألف دينار؛ مكافأة له؛ لأنَّه قام بتزويج سكينة له.
كما استنتج أنّ السيّدة سكينة كانت مضطرّة من الزواج بمصعب، هذا بالإضافة إلى أنَّ حياتهما الزوجية كانت غير متوافقة، ذكر أبو الفرج الأصفهاني: لمّا كان يوم قتل مصعب دخل على سكينة بنت الحسين÷، فنزع عنه ثيابه ولبس غِلالة، وتوشّح بثوب وأخذ سيفه، فعلمت سكينة أنّه لا يرجع فصاحت من خلفه واحزناه عليك يا مصعب، فالتفت إليها ـ وقد كانت تخفي ما في قلبها منه ـ وقال: أو كلُّ هذا لي في قلبك؟ لو كنت أعلم أنّ هذا كلّه لي عندك لكان لي ولك حال، ثمّ خرج ولم يرجع([452]).
كما يذكر المازندراني: «أنَّ مصعباً خطبها بعد واقعة الطّف من علي بن الحسين×، ولم يرضَ الإمام× بذلك؛ لأنّه عرف منها عدم القبول، ولمّا كان مصعب والياً على العراقين وكانت له الرياسة، وله قوة وشوكة واقتدار، أصرَّ على ذلك وخوّفهم وهدّدهم، وقال لابدّ لي من هذا الأمر، وبينهم قرابة قريبة؛ لأنّ أباه الزبير بن صفية، وهي بنت عبد المطّلب بن هاشم، عمّة الرسول والزبير بن العوام، والعوام قيل: أخو خديجة بنت خويلد، وليس بمعلوم، ومع ذلك لا يُعتني بشأن مصعب، ومسألة كثير... ولما أصرَّ مصعب على هذا الأمر ولم تكن لأهل البيت حجّة في الخلاص منه رضوا بذلك، وزوّجوها منه بستمائة ألف درهم»([453]).
هذه الروايات هي محاولة انتقاص من مكانة الإمام زين العابدين×؛ إذ إنّ المفهوم منها أنّ الإمام السجاد× كان يخشى الضغط من قبل ابن الزبير، فحمل أخته وزوّجها لمصعب؛ تجنّباً للمشاكل السياسية. والسؤال هنا متى كان الإمام يخشى مثل هكذا أشخاص؟! ويرضخ للضغط وللتسلّط وهو ابن الحسين× الثائر على الطاغية يزيد؟!
كما يضاف إلى ذلك أنَّ الإمام زين العابدين× لم يمارس أيّ أسلوب سياسي، وكان يجنِّب نفسه السياسة، مقبلاً على العبادة، فكان الإمام زين العابدين متفرغاً للعمل العبادي، منصرفاً للدعاء، لكنَّ هذا لا يعني أنّه ترك الأمّة نهباً للطواغيت المنحرفين؛ لأنّ السياسة ليست بالضرورة أن تتحدّد في اتخاذ المواقف المعارضة للنظام وحمل السلاح، فالعمل السياسي عند أهل البيت يكون من خلال ممارسة قيادة الأمّة نحو الصلاح والرشاد، وبيان الأفكار الأصيلة، وتحديد معالم الإسلام والتفاصيل التشريعية المرتبطة بالجوانب الفردية والإجتماعية.
فقد مارس الحكّام الأمويون السياسة التشويهية لمقام أهل البيت^، وموقعهم من الرسول ومن الأمّة، حيث أدّت تلك السياسة إلى حرمان الأمّة من فرصة معرفة أهل البيت^، وتلقِّي الإسلام عنهم بوصفهم أمناء الله على حلاله وحرامه، وبوصفهم الإمتداد التكويني والسياسي للرسول|، ففي وسط هذه الظروف القاسية، وخصوصاً بعد شهادة الإمام الحسين× وأهله وأنصاره، والتصفيّات الدموية للمنتمين لمدرسة أهل البيت^، وفي وسط الحملات الإعلامية المسعورة ضدّ أهل البيت؛ تولّى الإمام السجاد× مسؤولية تعميق مفهوم الإمامة ([454]).
فقد مارس النشاط السياسي من خلال توضيحه للطريق الصحيح فيقول: ليس بين الله وبين حجته حجب، ولا لله دون حجته ستر، فنحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم، ونحن عَيبة علمه، ونحن تراجمة وحيه، ونحن أركان توحيده، ونحن موضع سرِّه([455]).
أمّا بخصوص إجبار السيّدة سكينة على الزواج من مصعب فهذه محاولة انتقاص من مكانة الإمام السجاد×، وهو غير مقبول؛ لأنَّ الإمام السجاد× في هذا الوقت كان يقوم بدور ولي الأمر للسيّدة سكينة، فلا يمكن أن يجبرها، كما أنَّ عبد الله بن الزبير لم يحكم سيطرته على المدينة بعدُ حتّى يتسنّى لأخيه مصعب قهر بني هاشم([456]).
وأمّا بخصوص تقبل الإمام السجاد× المال من مصعب فهذه محاولة انتقاص أخرى من شأن الإمام؛ إذ كان السجاد× موفور المال، غير محتاج، بل كان يساعد النّاس، وينفق على الرعية، ولا يقبل الصدقة أو العطية وغيرها، فقد رُوي أنّ علي بن الحسين÷ دخل على محمّد بن أسامة بن زيد([457]) في مرضه، فجعل محمّد يبكي، فقال علي×: ما شأنك؟ قال عليّ دين، قال: كم هو؟ قال: خمسة عشر ألف دينار، قال: فهو عليّ([458]).
كما رُوي أيضاً أنّ رجلاً كان يتعرّض لعلي بن الحسين÷، فأمر له الإمام بألف درهم وألقى عليه خميصة كانت عليه، فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنَّك من أولاد الرسول([459]).
فلم يحتج الإمام إلى عطاياهم، وعلى حدِّ قول الحلو([460]): متى عُرف آل الزبير بالعطاء؟بل لم يُرَ منهم سوى الشُّحّ والضيق على الرعية، حتّى ضجَّ النّاس من بخل آل الزبير.
ويصف المسعودي شحَّهم قائلاً: «كثرت أذيته لبني هاشم مع شحِّه بالدنيا على سائر النّاس، ففي ذلك يقول أبو حرّة مولى الزبير:
|
إنَّ الموالي أمست وهي عاتبة أيُّ الملوكِ على ما حولَنا غلبا»([461]). |
ويقول الضحاك بن فيروز الديلمي([462]):
|
«تخبرنا أن سوفَ تكفيكَ قبضة فلو كنتَ تجزي إذ تبيت بنعمة |
كما كتب أنس بن زنيم الليثي إلى عبد الله بن الزبير يشكو إليه بخل مصعب فقال:
|
«بضع
الفتاة بألفِ ألفٍ كامل |
وقبل أن نطرح مسألة زواج السيّدة سكينة من مصعب، لابدّ أن نستطلع أحوال مصعب سريعاً، وعلاقته بأهل البيت.
يُعتبر مصعب جزءاً من آل الزبير الذين لم يلبثوا أن استقرَّ النشاط السياسي لهم، فجهروا بعداوتهم لأهل البيت، وكان ابن الزبير لا يخفِي كراهيته لأهل البيت، فقال لعبد الله بن عباس: «إنِّي لا أكتم بغضكم أهل البيت منذ أربعين سنة»([465]).
ومع أنَّه كان يسعى لتحقيق أهدافه بكلِّ ثمن كان يمارس سلوكاً معادياً لأهل البيت، فيذكر ابن الأثير: «إنَّ ابن الزبير دعا محمّد بن الحنفية ومَن معه من أهل بيته وشيعته وسبعة عشر رجلاً من وجوه أهل الكوفة... ليبايعوه، فامتنعوا وقالوا: لا نبايع حتّى تجتمع الأمَّة، فأكثر الوقيعة في ابن الحنفية وذمّه... فلمّا استولى المختار على الكوفة وصارت الشيعة تدعو لابن الحنفية، خاف ابن الزبير أن يتداعى النّاس إلى الرضا به، فألحَّ عليه وعلى أصحابه في البيعة له، فحبسهم بزمزم، وتوعّدهم بالقتل والإحراق، وأعطى الله عهداً إن لم يبايعوا أن ينفذ فيهم ما توعّدهم به، وضرب لهم في ذلك أجلاً»([466]).
كما ذكر اليعقوبي أيضاً: «تحامل عبد الله بن الزبير على بني هاشم تحاملاً شديداً، وأظهر لهم العداوة والبغضاء، حتّى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على محمّد في خطبته، فقيل له: لم تركت الصلاة على النبي؟ فقال: إنّ له أهل سوء يشرئبون لذكره، ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به»([467]).
هذه سياسة عبد الله بن الزبير، فكيف يكون مصعب الذي قتل المختار بن يوسف الثقفي، الذي طهّر الأرض من قتلة الإمام الحسين×، فقد طاردهم وقتلهم تحت كلِّ حجر ومدر؟ وقد بُليت الأمَّة بعبد الله بن الزبير وأخيه مصعب، فقد استوليا على الحجاز والعراق، وأبادا بصورة جماعية شيعة أهل البيت^، وفي طليعتهم حاكم العراق المختار، ولكن لم يستتبَّ الأمر لمصعب وأخيه فقد قتلهما عبد الملك([468]).
وليس هذا فقط، بل تذكر المصادر أنّ سكينة كانت مع مصعب في الكوفة عندما خرج له عبد الملك، ولما قُتل أرادت الرحيل إلى المدينة، فقال لها أهل الكوفة: يا بنت رسول الله أحسن الله صحابتك، فقالت: يا أهل الكوفة: لا أحسن الله صحبتكم؛ فقد قتلتم جدي علياً، وعمّي الحسن، وأبي الحسين، وبعلي مصعباً، فأيتمتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة، فلا أحسن الله عليكم الخلافة ([469]).
وهذه محاولة أموية، الغرض منها إلقاء مسؤولية قتل الحسين× على أهل الكوفة، محاولين أن يجرّدوا أنفسهم ممّا ارتكبوا في حقِّ سبط الرسول|، فالكوفة عُرفت بولائها لهذا البيت، ولا يمكن للتاريخ أن ينكر ما ارتكبه هؤلاء من سفك دماء الأطهرين.
كما أنَّ مصعباً هو نموذج سييء، ومساوئه كثيرة، منها أنه عمل على حماية قتلة الحسين× وإخفائهم عن المختار عندما أراد قتلهم، فقد روي أنَّ المختار بعث غلاماً له يُدعى زربياً في طلب شمر بن ذي الجوشن، وكان ممَّن قتل شمر أباه فما كان من شمر... حتّى ينزل إلى جانب قرية يقال لها الكلتانية ([470]) على شاطئ نهر إلى جانب تل، ثمّ أرسله إلى تلك القرية فضربه، ثمّ قال النجاء بكتابي هذا إلى مصعب بن الزبير، وكتب عنوانه للأمير مصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن، فأراد أن يلتحق بمصعب بن الزبير إلاّ أنَّه عُثر على هذا الكتاب وعنوانه لمصعب من شمر، فدارت معركة قُتل فيها شمر([471]).
كما كان سراقة بن مرداس البارقي([472]) قد أسره المختار، فلمّا أحسَّ بالقتل عمل حيلة للنجاة فنجا بها، قال: ما كنت في أيماني هذه حلفت بها قط أشدّ اجتهادا ولا مبالغة في الكذب مني في أيماني هذه التي حلفت لهم بها، إنّي قد رأيت الملائكة معهم تقاتل، فخلّوا سبيله، فهرب، فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند مصعب بن الزبير بالبصرة، وخرج أشراف أهل الكوفة والوجوه، فلحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة([473]).
كما ذُكر أيضاً أنَّ المختار طلب سنان بن أنس الذي قتل الحسين×، فلحق بالبصرة، ثم هرب إلى مصعب، وهدم المختار داره، وطلب آخرين كذلك من المتهمين بأمر الحسين× فلحقوا بمصعب، وهدم دورهم([474]).
وفي رواية أخرى طلب المختار رجلاً من خثعم يُقال له: عبد الله بن عروة الخثعمي([475])ـ كان يقول: رميت فيهم باثني عشر سهماً ضيعة ، ففاته، ولحق بمصعب، فهدم داره([476]).
هكذا كان مصعب يؤوي قتله الحسين× إلى جانبه، فهل يُعقل أنَّ السيّدة سكينة تكون واقفة إلى جانب هؤلاء، وتعلم أنَّ مصعباً يقتل المختار، وما السبب الذي دفع الإمام السجاد بأن يزوّج أخته× لمصعب قاتل المطالبين بدم الحسين×؟!
يذكر المسعودي: «كانت جملة مَن أدركه الإحصاء ممَّن قتله مصعب مع المختار سبعة آلاف رجل، كلُّ هؤلاء طالبوا بدم الحسين× وقتلة أعدائه، فقتلهم... وتتبّع مصعب الشيعة بالقتل بالكوفة وغيرها، وأُتى بحرم المختار، فدعاهنَّ إلى البراءة منه، ففعلن إلاّ حرمين له: إحداهما بنت سمرة بن جندب الفزاري، والثانية ابنة النعمان بن بشير الأنصاري، وقالتا كيف نتبرّأ من رجل يقول ربي الله؟ كان صائماً نهاره وقائما ليله»([477]).
هذا يكشف لنا الحقد والعداء لأهل البيت، فما السبب الذي يجعل الإمام السجاد يقبل هذا التقارب؟ إذاً لا يمكننا قبول حكاية زواج مصعب بن الزبير لسكينة، وهذه محاولة قصصية يُراد من وضعها وافتعالها إلغاء ما عُرف من تقليدية العداء الزبيري ـ العلوي ـ وإظهار التوافق بين البيتين، ومحاولة إسباغ الشرعية على حركة آل الزبير هذا من جهة، ومن جهة أخرى هي محاولة إضفاء الشَّبَه بين تصرّفات عائشة بنت طلحة زوجة مصعب المعروفة بلهوها وترفها، وبين السيّدة سكينة، والتعامل معها على أساس ما يتعامل به نساء الزبيريين والأمويين، والتقليل من شأن مسحة الإحتشام والتعفُّف على نساء أهل البيت الطاهر، والخلط بين نساء الزبيريين والأمويين من انتهاكات شرعية ومخالفات عرفية ورميها على أهل البيت^([478]).
لقد ذكر سبط بن الجوزي: «وأول من تزوّجها مصعب بن الزبير قهراً»([479]).
كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني: «عندما أراد مصعب الخروج إلى القتال كانت تخفي ما في قلبها منه...»([480]).
وعليه فإنَّ عدم وقوع الزواج، وعدم وجود تقارب طوال هذه الفترة، وحالة العداء والكراهية؛ واضحة بين الطرفين.
أمّا مسألة القهر فهذا كلام مرفوض؛ لعدم استطاعة أحد أن يجبر الإمام علي بن الحسين÷، فهو يمثِّل الأنموذج الأمثل في هيمنته على القلوب، فقد هابه الخلفاء واحترموه، فقد ذكر ابن سعد: «أنَّ عليَّ بن الحسين كان يحبُّه عبد الملك ومروان بن الحكم»([481])؛ حيث كتب عبد الملك إلى الحجاج وهو على الحجاز: جنّبني دماء آل أبي طالب، فإنِّي رأيت آل حرب لما تهجّموا بها لم يُنصَروا([482]).
هذه مكانة آل البيت^ في قلوب النّاس، فمتى يُتاح لمصعب وأمثاله أن يقهروا أهل البيت^، وهذه الحادثة لايمكن قبولها، والدليل على ذلك واقعة السيّدة فاطمة بنت الحسين÷، التي حاول عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري أن يتزوّجها قهراً، فقد ذكر اليعقوبي: «خطب عبد الرحمن فاطمة بنت الحسين بن علي، فأرسل إليها رجالاً يحلف بالله لأن لم تفعلي ليضربنَّ أكبر ولدها بالسياط، فكتبت إلى يزيد كتاباً، فلمّا قرأ كتابها سقط عن فراشه، وقال: لقد ارتقى ابن الحجام مرتقى صعباً، مَن رجل يسمعني ضربه وأنا على فراشي هذا؟ فكتب إلى عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضري([483]) وكان بالطائف أن يتولّى المدينة، ويأخذ عبد الرحمن بن الضحاك بأربعين ألف دينار، ويعذّبه حتّى يسمعه ضربه، ففعل ذلك، فرُئي عبد الرحمن وفي عنقه خرقة صوف يسأل النّاس»([484]).
هكذا كانت نتيجة مَن يقهر بنات الرسالة، فكيف يمكن أن يقهر مصعب السيّدة سكينة؟!
قد يرى بعضٌ أنّ زواج مصعب من سكينة هو زواج سياسي، أهدافه أبعد مدى، فمصعب بن الزبير كان والياً على العراق، أي في بلد كان تأييده للجانب العلوي أكبر ما يكون لأي بلد آخر؛ ولكي يتمكّن مصعب من هذا البلد كان عليه أن يتزوّج من امرأة تنتسب إلى البيت العلوي، وبذلك يكون مصعب أكثر قرباً من أهل العراق ويكونون هم أكثر اتباعاً له([485]).
والحقيقة أنَّ الأحداث السياسية الهائجة كانت تُوحي بفشل حركة آل الزبير، وعدم رغبة النّاس فيهم، والإمام السجاد× لم يجازف في تأييد حركة ابن الزبير التي ستؤول إلى السقوط، وما يتحمّل من تبعات ذلك من قِبَل بني أميّة، ولذلك انعزل× عن هذه الأحداث؛ لترك الأمور تنقشع وشيكاً عن هزيمة ابن الزبير وغلبة عبد الملك ابن مروان، ومن ثَمَّ فإنَّ الفريقين غير جديرين بالنصرة والمبايعة، وكلاهما طلّاب مناصب واتباع دنيا، والدِين لَعق على ألسنتهم، فأية توافق يبديه الإمام زين العابدين مع آل الزبيرـ حتّى على مستوى المصاهرة ـ يُعدُّ توافقاً سياسياً وتأييداً شرعياً في حسابات النظام الأموي القادم، فهل يبقى أدنى احتمال لإمكانية التقارب بين آل الزبير وبين الإمام× حتّى يعمد إلى مصاهرة مصعب بن الزبير([486]).
لقد ذُكر أنّ مصعب بن الزبير كتب إلى زوجته سكينة بنت الحسين÷ بعد خروجه من الكوفة بليال:
|
«وكان
عزيزاً أن أبيت وبيننا |
إلا أنَّ هذه الأبيات قالها مروان بن محمّد لجاريته عندما هُزم نحو مصر فقال:
|
«وما زال يدعوني إلى الصمد ما أرى |
هكذا تلاعب رجال التاريخ وأخذوا ينسبون الأشعار إلى السيّدة سكينة؛ لكي يتبرَّوا من مخازي الأمويين ويلقوها على أشرف الأسر.
وبالتالي فإنَّ زواج السيّدة سكينة من مصعب بن الزبير غير مقبول، فهنالك خلط كبير في الروايات التاريخية دفعتهم إلى نسبة هذا كلّه للسيّدة سكينة، ولابدّ من الإشارة إلى أنَّ مصعب بن الزبير لديه بنت اسمها سكينة، وأمُّها أُمُّ ولد([489]).
كما أنَّ زوجته عائشة بنت طلحة تميّزت بقول الشعر، وكانت جميلة لا تستر وجهها عن أحد([490])، وقد حدَّثها مصعب في ذلك، حيث قالت: «إنّ الله تعالى وسَمَني بميسم
جمال، فأحببت أن يراه النّاس، والله ما بي وصمة استتر لها»([491]).
وكان يُقال فيها أشعار([492])، ولها أخبار مشهورة مع الشعراء([493])، كما تميَّزت بالزواج من عدّة أزواج، فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني: «كانت عند عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، وكان أبا عذريتها، ثمّ هلك، فتزوَّجها مصعب فقُتل عنها، ثمّ تزوَّجها عمر بن عبيد الله بن معمر...»([494]).
وكما ذُكر أنَّ للسيّدة سكينة بنت الحسين÷ بنتاً من مصعب، سمَّتها باسم أُمِّها الرباب، فلمّا قُتل مصعب ولي أخوه عروة تركته، فزوّجها (الرباب بنت مصعب) ابنه عثمان بن عروة، فماتت وهي صغيرة، فورثها عثمان بن عروة عشرة آلاف دينار([495]).
وقد روي أنَّ سعدة بنت عبد الله بن سالم قالت: لقيت سكينة بنت مكّة ومنى فقالت: قفي لي يا ابنة عبد الله، فوقفت، فكشفت عن بنتها من مصعب، فإذا هي قد أثقلتها بالحلي واللؤلؤ، فقالت: ما ألبستها إيّاه إلاّ لتفضحه([496]).
وهنا لا مجال للإطمئنان إلى خبر عبث به الرواة على هذا النحو، ولا يوجد في مراجعنا الأخرى ما يشير إلى أنّها ولدت من مصعب بنتاً، ولو كان هذا صحيحاً لكان مصعب الزبيري([497]) أولى بذكر هذا الخبر.
كما أنَّ رواة الأخبار لم يذكروا لنا شيئاً عن حياة السيّدة سكينة ومصعب، مع أنَّهم ملأوا سمع الأجيال بدقائق حياته الزوجية مع عائشة بنت طلحة، لدرجة ذكروا مواصفاتها كاملة ([498])، وأكثروا من تفاصيل الحياة الزوجية، بينما لم تُذكَر أيُّ تفاصيل عن حياته الزوجية المزعومة مع السيّدة سكينة، وهذا دليل على عدم وجود أيِّ علاقة زوجية أصلاً. وأمّا سكينة التي رافقته إلى العراق فهي ابنته، وليست سكينة بنت الحسين÷.
وأمّا ما ذكره أبو الفرج الأصفهاني: «خطب سكينة بنت الحسين عبد الملك بن مروان فقالت أُمُّها: لا والله، لا يتزوجها أبداً وقد قتل ابن أخي، تعني مصعباً»([499]).
فهذه الرواية مضطربة جداً وغير صحيحة، وتؤكِّد عدم صحة أدِّعاءات أبي الفرج؛ حيث ذكرت المصادر أنَّ الرباب بنت امرئ القيس عندما عادت من واقعة كربلاء ورجعت إلى المدينة، بقيت بعده سنة لم يظلّها سقف وماتت كمداً([500])، فكيف تكون أُمُّ سكينة على قيد الحياة بعد وفاة مصعب 72هـ/691م، وتمنع ابنتها من زواج عبد الملك؟! لقد حاول أبو الفرج الأصفهاني أن يتّهم بنات الرسالة، وذلك من أجل تطميس مبادئ الثورة الحسينية وإشغال النّاس بمثل هذه الأخبار.
2ـ شبهة الزواج من عبد الله بن عثمان
أمّا بالنسبة لزواج السيّدة من عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم، فهي قصّة أخرى افتعلها بعض رجال التاريخ، وكلُّ ما ذكره هؤلاء حول هذا الزواج هو: أنَّ عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم، أُمُّه رملة بنت الزبير بن العوام؛ كان متزوجاً من فاطمة بنت عبد الله بن الزبير، ثمّ تزوّج سكينة بنت الحسين÷، فولدت له عثمان ابن عبد الله بن عثمان، ولقّبته قريناً وحكيماً ([501]).
ولقد رُوي أنَّ سكينة بنت الحسين÷ توهّمت بأنَّ عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن حكيم ـ وهي زوجته ـ طلّقها، فاستعدت عليه، فدخلت رملة بنت الزبير على عبد الملك بن مروان وقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ سكينة بنت الحسين÷ نشزت بابني عبد الله بن عثمان، ولولا أن تغلب على أمورنا ما كانت لنا حاجة بمن لا حاجة له بنا، فقال لها عبد الملك: يا رملة، إنّها ابنة فاطمة ! فقالت: نطحنا والله خيرهم، وانكحنا والله خيرهم، وولدنا خيرهم([502]).
وفي رواية أخرى قال المدائني عن مجالد، عن الشعبي قال: «نشزت سكينة بنت الحسين على عبد الله بن عثمان بن عبد الله، فدخلت أُمُّه رملة بنت الزبير على عبد الملك فأخبرته بنشوز سكينة على ابنها، وقالت: يا أمير المؤمنين لولا أن نُبتزَّ أمورنا لم تكن لنا رغبة فيمَن لا يرغب فينا، قال: يا رملة إنَّها سكينة، قالت: وإن كانت سكينة، فوالله لقد ولدنا خيرَهم، ونكحنا خيرَهم»([503]).
هذا استعراض للروايات التي ذكرت خبر هذا الزواج، وحقيقته أنَّ رواتها هم الزبير بن بكار، وكذلك مجالد.
فأمّا ابن بكّار فقد مرَّالحديث عنه، وأمّا مجالد فقد ضعّفه رجال الجرح والتعديل، فيقول عنه ابن عدي: «عن بشر بن آدم، قلت لخالد بن عبد الله الواسطي: دخلتَ الكوفة، وكتبت عن الكوفيين ولم تكتب عن مجالد، قال: لأنَّه كان طويل اللحية...، وكان يحيى بحديثها...، وقال السعدي: مجالد بن سعد يضعُف حديثه...»([504]).
ومن الغريب في هذه الروايات أنَّ رملة بنت الزبير تشتكي لعبد الملك وهو قاتل أخيها، فهل انقرضت الحجاز من الرجال لكي تشكو زوجة ابنها لعبد لملك؟! وهل عبد الملك متفرّغ للقضايا الزوجية؟!
3ـ شبهة الزواج من الأصبغ بن عبد العزيز
أمّا بخصوص الزواج الثالث فقد اختلفت المصادر في تحديد الأصبغ مَن هو؟ إلاّ أنَّ أغلب المصادر اتّفقت على أنَّه الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان([505]).
على الرغم من أنَّ هذا الخبر قد ورد في المصادر قبل أبي الفرج الأصفهاني، إلاّ أنَّه انتحل قصّة لهذا الزواج قائلاً: « ثمّ خلف عليها العثماني، ثمّ مصعب الزبيري، ثمّ الأصبغ ابن عبد العزيز بن مروان، فقال فيه بعض المدنيين:
|
نُكِحت سكينة بالحسابِ ثلاثة |
وكان يتولَّى مصر، وكتبت إليه أنَّ أرض مصر وخمة، فبنى لها مدينة تُسمَّى مدينة الأصبغ، وبلغ عبد الملك تزوُّجه إيّاها، فنفس بها عليه، فكتب إليه اختر مصر أو سكينة، فبعث إليها بطلاقها ولم يدخل بها، ومتَّعها بعشرين ألف دينار»([506]).
لو تتبّعنا كتب التاريخ لم نجد الأصبغ والياً على مصر في عهد عبد الملك بن مروان (65ـ86هـ/684ـ705م)، بل كان عبد العزيز بن مروان، وقد تُوفِّي سنة 85هـ/704م، فضمَّ عبد الملك عمله إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك، وولّاه مصر([507]).
وقد ردَّ المقريزي على أبي الفرج قائلاً: «قلتُ هذا الخبر أوهام، منها: إنَّ الأصبغ لم يكن في مصر...»([508]).
كما أكَّدت بنت الشاطئ على أنَّ الزواج من الأصبغ لم يتمَّ؛ معلِّلة ذلك بعدم ورود تفاصيل هذه الخطبة في نسب قريش، ولا في جمهرة أنساب العرب([509]).
ويذكر ابن حزم الأندلسي: «تزوّجت سكينة بنت الحسين من سهيل بن عبد العزيز ابن مروان»([510]).
وهذا اضطراب آخر، أو اسم زوج جديد لسكينة، وهذا ما يجعلنا نشكُّ أكثر في الرواية.
وعلى أيَّة حال فإن كان الزوج الأصبغ بن عبد العزيز، أو سهيل بن عبد العزيز، فقصة هذا الزواج مرفوضة، لا يمكن تقبّلها.
4 ـ شبهة الزواج من زيد بن عمرو بن عثمان
أمّا الزواج الرابع فقد اتفقت أغلب المصادر ـ التي تذكر تعدد زواجات سكينة ـ على أنّه من زيد بن عمرو بن عثمان([511])، ذكر أبو الفرج الأصفهاني في أخبار هذا الزواج: «أنَّ زيد بن عمرو بن عثمان العثماني خرج إلى مال له مغاضباً سكينة، وعمر بن عبد العزيز يومئذ والي المدينة، فأقام سبعة اشهر فاستعدته سكينة على زيد، وذكرت غيبته مع ولائده سبعة أشهر، وأنها شرطت عليه أنّه إن مسَّ امرأة أو حال بينها وبين شيء من ماله، أو منعها مخرجاً تريده، فهي خلية، فبعث إليه عمر فأحضره، وأمر ابن حزم أن ينظر بينهما... فدخلنا عليه وعنده زيد جالس وفاطمة امرأة ابن حزم في الحجلة، وجاءت سكينة، فقال ابن حزم: ادخلوها وحدها، فقالت: والله لا أدخل إلاّ ومعي ولائدي، فأُدخِلن معها، فلمّا دخلت قالت: يا جارية أثني لي هذه الوسادة، ففعلت وجلست عليها، ولصق زيد بالسرير حتّى كاد يدخل في جوفه خوفاً منها، فقال لها ابن حزم: يا ابنة الحسين إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحبُّ القصد في كلِّ شيء، فقالت له: وما انكرت منّي، إني وإياك والله كالذي يرى الشعرة في عين صاحبه ولا يرى الخشبة في عينه، فقال لها: أما والله لو كنتِ رجلاً لسطوت بك، فقالت له: يا بن فرتني ألا تزال تتوعدني؟ وشتمته وشتمها، فلما بلغا ذلك قال ابن أبي الجهم العدوي: ما بهذا أمرنا فأمضِ الحكم ولا تشاتم، فقالت لمولاة لها: من هذا؟ فقالت: أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجهم فقالت: لا أراك ههنا وأنا أُشتم بحضرتك، ثمّ هتفت برجال قريش وحضّت ابن أبي الجهم وقالت: أما والله لو كان أصحاب الحرّة أحياءً لقتلوا هذا العبد اليهودي عند شتمه إياي، أي عدوَّ الله تشتمني وأبوك الخارج مع يهود صبابة بدينهم لمّا أخرجهم رسول الله إلى اريحاء يابن فرتنى، قال وشتمها وشتمته»([512]).
وفي هذه الرواية يزعم أبو الفرج أنَّ السيّدة سكينة تشترط على زوجها الرابع شروطاً عجيبة؛ ألاّ يمسّ امرأة سواها، وألّا يحول بينها وبين شيء من ماله، وألّا يمنعها مخرجاً تريده، فإن أخلَّ بأحد هذه الشروط فهي منه خلية، وقد يتّضح أنّ الشرط الأول غريب من سكينة حفيدة نبي الإسلام الذي أباح تعدّد الزوجات، وكان تعدّد الزوجات في بيئتها العرف المتبع والشائع، والشرط الثاني أغرب؛ فزيد هذا أبخل قرشي فيما قالوا، وقد رووا عنه الأعاجيب يكاد المرء لغرابتها أن يتهمها بالوضع، كما يزعم أنّها امرأة مترفة تسير معها جواريها، ولا تجلس إلاّ على وسادة، وتخاف منها الرجال، ثمّ تبدأ تتكلّم وتتجادل مع الرجل الغريب وتشتمه ويشتمها! وكأنَّها ليست حفيدة رسول الله|.
وفي رواية رواها أشعب([513]) قال: «تزوّج زيد بن عمرو بن عثمان بن عفّان سكينة وكان أبخل قرشي رأته، فخرج حاجّاً وخرجت سكينة معه، فلم تدع أوزة ولا دجاجة وخبيصاً ولا فاكهة إلاّ حملته معها، وأعطتني مائة دينار، وقالت: يا ابن أم حميد اخرج معنا فخرجت... على خمسة أجمال فلمّا أتينا السيالة نزلنا، وأمرت بالطعام أن يقدّم، فلمّا جِيء بالأطباق أقبل أُغيلمة من الأنصار يسلمون على زيد، فلمّا رآهم قال: أوّه خاصرتي باسم الله ارفعوا الطعام، وهاتوا الترياق والماء الحار... وجاءته مشيخة من قريش يسلِّمون عليه فلمّا رآهم اعتلَّ بالخاصرة، ودعا بالترياق والماء الحار...»([514]).
هكذا افتعل الأصفهاني قصّة للصق هذا الزواج باسم السيّدة سكينة، مبيّناً فيها إسراف سكينة، وبخل زوجها، وتناقض الشخصيتين.
كما روى الزبير بن بكار قال: «حدّثنا شعيب بن عبيدة بن أشعب عن أبيه، عن أبيه عن جدّه قال: كانت سكينة بنت الحسين بن علي عند زيد بن عمرو بن عثمان بن عفّان، قال: وقد كانت أحلفته ألاّ يمنعها سفراً ولا مدخلاً ولا مخرجاً، فقالت: اخرج بنا إلى حمران من ناحية عسفان، فخرج بها فأقامت، ثمّ قالت له: اذهب بنا نعتمر، فدخل بها مكّة، فأتاني آت فقال: تقول لك ديباجة الحرم ـ وهي امرأة من ولد عتاب بن أسيد ـ لك عشرون ديناراً إن جئتني بزيد بن عمرو الليلة في الأبطح، قال شعب: أنا أعرف سكينة وأعلم ما هي، ثمّ غلب عليَّ طباع السوء والشَّره، فقلت لزيد فيما بيني وبينه: إنَّ ديباجة الحرم أرسلت إلى بكيت وكيت... فلم ننشب أن سمعنا شحيج بغلة سكينة، فلمّا استبانها زيد قام فأخذ بركابها، واختبأت ناحية وقبّلتها بين عينيها وأجلستها، فقامت الديباجة إلى سكينة فتلقّتها وقبّلت بين عينيها وأجلستها على الفراش، وجلست هي على بعض النمارق([515])... ثمّ أمرت بالرحيل إلى الطائف فأقامت بالطائف، وحوّطت من ورائها بحيطان ومنعت زيداً أن يدخل عليها، قال ثمّ قالت لي يوماً: قد أَثِمنا في زيد وفعلنا ما لا يحلُّ لنا» ([516]).
وهذا الخبر لا ينسجم مع امرأة سرية عاقلة، همُّها فقط الخروج من المدينة، ثمّ عودتها إليها، ثمّ خروجها منها، كما تروي خيانة زوجها، ثمّ تكشفه بسرعة وكأنَّها تضع مَن يراقبه. كما تشترط عليه شروطاً قاسية، وتحلِّفه ألاّ يتزوَّج عليها، ولا يتسرَّى ولا يلمَّ بنسائه وجواريه إلاّ بإذنها.
وحجّ الخليفة في سنة من السنين فقال لها: لا بدّ والخروج للقائه، فشرطت عليه أن لا يدخل الطائف، وحلَّفته بالطلاق، ولم تكتفِ بذلك، فقد وضعت عليه أشعب يراقبه، وأن يمنع زوجها من دخول الطائف، وحلَّفته بطلاق زوجته بنت وردان إذا لم يمنعه، وأعطته ثلاثين ديناراً، ولمّا ساروا رشاه زيد بثلاثمائة دينار فقبلها أشعب، فخان زوجته، فلمّا لقي الخليفة رجع، فسألته على دخوله الطائف، فقال لها: سلي ثقتك ، فأنكر أشعب، إلاّ أنَّ زيداً أخبرها بالحقيقة، فعاقبت أشعب، حيث شَرت بيضاً وجعلته يحضن البيض حتّى يفقِّس، وبعد أربعين يوماً فقسَ البيض وخرج منه فراريج كثيرة، فربَّتْها وتناسلت، فكانت بالمدينة تسمَّى بنات أشعب ونسل أشعب([517]).
يقول إبراهيم لما سمع هذه الرواية: «ضحكت والله من قوله ضحكاً ما أذكر أني ضحكت مثله قط»([518]).
وهذا دليل على أنَّ صاحب الرواية ـ وهو أشعب ـ كان يرغب في أن يضحك النّاس ولا يهمه سوى الحصول على المال، فقد عُرف بالطمع لدرجة كان يقول: ما خرجت في جنازة قطُّ ورأيت اثنين يتسارّان إلاّ ظننت أنَّ الميت قد أوصى لي بشيء([519]).
يقول الكتبي: «من عجائب أمره أنه لم يمت شريف بالمدينة إلاّ استعدى على وصيِّه أو على وارثه، وقال له: احلف أنَّه لم يوصِ لي بشيء قبل موته»([520]).
وقال عنه: لا يُكتَب حديثه([521])، وقيل: في سنده نوادر([522])، وكان قد تعلَّم الغناء من عبد([523]).
لقد أخذ أشعب يثير الكثير من القصص حول زواج السيّدة سكينة من العثماني؛ وذلك من أجل أخذ المال فقط، كما أنّ هذه الروايات لا يمكن أن نقبلها إطلاقاً؛ وذلك لما يرويه من أنَّ سكينة وضعت شروطاً قبل الزواج وقيّدته بأن لا يمسّ امرأة غيرها، وهذا يدلُّ على عدم قناعة الزوجة، ومعرفتها بطباع الخاطب، فما الذي يجبر أيَّ امرأة كانت أن تتزوج من رجل لا تؤمن به؟! والمعهود من ربّات الخدور وبنات البيوت الغيورات على أنفسهنّ، اذا كان من قضى عنهنّ أكفاء كراماً، فلا يعطين بهم بدلاً.
وقد ذُكر أنه تزوّجها زيد بن عمرو بن عثمان بن عفان، فأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها ففعل([524]).
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الخليفة متفرّغ لهكذا قضايا عائلية؟! وهل مثل هذا الخليفة له ولاية على نساء آل أبي طالب؟!
ومن الشواهد التي تنفي هكذا أخبار وصيةُ الحسن المثنى، وهو زوج فاطمة بنت الحسين÷، وذلك لمّا احتضر حذّر فاطمة من الزواج بعده من عبد الله بن عمرو لاعتبارات عدّة([525]).
ولا شكّ أنّ سكينة لا تجهل هذه القضية، فكيف تتزوج من هذه الأسرة؟!
كما أنّ هناك مسألة مهمّة تؤكِّد عدم صحة هذا الزواج، يقول الزبيري: «أمّا زيد بن عمرو بن عثمان بن عفّان فانقرض ولده، قُتل منهم ثلاثة نفر كانوا لأمِّ ولد بنهر أبي فطرس([526])، مع مَن قُتل من بني أميّة زمن مروان بن محمّد، وزيد بن عمرو بن عثمان هذا هو الذي كانت عنده سكينة بنت الحسين، فهلك عنها فورثته»([527]).
المفهوم من هذه الرواية أنّ أولاد زيد تُوفّوا سنة 132هـ/749م في أواخر خلافة مروان بن محمّد، ولم يبقَ له أحد يرثه، فجاءت السيّدة سكينة فورثته.
ويُشكل هنا أنّه كيف ترث سكينة رجلاً تُوفي ورثته سنة 132 هـ/749م وهي تُوفيت سنة 117هـ/735م؟! باعتقادي أنَّ هذا الخبر أُلصق مؤخّراً في نسب قريش، وهي من الشبهات التي لا يمكن تصديقها.
ولو قلنا: هناك التباس في الرواية، وأولاده أحياء قبل هذه الفترة، وطلّقها سليمان ابن عبد الملك من زيد، فكيف ترثه وأولاده على قيد الحياة؟!
كما نلاحظ اختلافاً كبيراً بين الشخصيتين، بين السيّدة سكينة التي كانت من أهل الجود والفضل، وبين ذلك الرجل الذي يأبى أن يشاركه في الطعام والشراب ضيوفه([528]).
5ـ شبهة زواجها من إبراهيم بن عبد الرحمن
نُسِب للسيّدة سكينة زواج آخر من إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، حيث ذكرت بعض المصادر أنّها تزوجته ولم يتمّ نكاحه؛ حيث فرّق بينهما هشام بن عبد الملك([529]). وقيل: خُيِّرت فاختارت نفسها([530]). وقيل: بقيت معه ثلاثة أشهر([531]).
أمّا مضمون هذا الزواج فقد انفرد به أبو الفرج الأصفهاني، فروى: «أنَّ إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف خطبها بعد مقتل مصعب، فبعثت إليه: أبلغ من حمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت رسول الله تخطبها، فأمسك عن ذلك»([532]).
ومن الغريب أنَّ هذا الخاطب يطلبها من نفسها ـ كأنّها لم يُعرَف لها أحدٌ، وكأنَّها مقطوعة من شجرة النسب ـ وترفضه مفتخرة بنسبها، ولكن سرعان ما تتردَّد وتغيّر رأيها مجرّد أن رأت جاريتها تتمنّى أن ترى العرس.
يقول أبو الفرج الأصفهاني: «تنفّست يوماً بنانة جارية سكينة وتنهّدت، حتّى كادت أضلاعها تتحطّم، فقالت لها سكينة: مالكِ ويلكِ؟قالت: أحب أن أرى في الدار جلبة، تعني العرس، فدعت مولى لها تثق به، فقالت له: اذهب إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف فقل له: إنَّ الذي كنّا ندفعك عنه قد بدا لنا فيه، أنت من أخوال رسول الله؛ فأحضِر بيتك، قال: فجمع عدَّة من بني زهرة وأفناء قريش من بني جُمح وغيرهم نحواً من سبعين رجلاً أو ثمانين، ثمّ أرسل إلى علي بن الحسين والحسن بن الحسن وغيرهم من بني هاشم، فلمّا أتاهم الخبر اجتمعوا، وقالوا: هذه السفيهة تريد أن تتزوّج إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فتنادى بنو هاشم واجتمعوا وقالوا: لا يخرجنَّ أحد منكم إلاّ ومعه عصا، فجاؤوا وما بقى إلاّ الكلام، فقال اضربوا بالعصى، فاضطربوا هم وبنو زهرة حتّى تشاجّوا، فشُجَّ بينهم يومئذ أكثر من مائة إنسان، ثمّ قالت بنو هاشم: أين هذه؟ قالوا: في هذا البيت، فدخلوا إليها فقالوا: أبلغ هذا من صنعك؟ ثم جاؤوا بكساء طاروقيّ فبسطوه، ثمّ حملوها وأخذوا بجوانبه، فالتفتت إلى بنانة فقالت: يا بنانة أرأيت في الدار جلبة؟ قالت: إي والله، إلاّ أنّها شديدة»([533]).
لقد زعم أبو الفرج الأصفهاني أنَّها تزوّجت من رجل؛ لمجرّد رغبة جاريتها بذلك، لدرجة أنَّ أهلها يتشاجرون ويشتمونها، وهي غير مهتمّة لكلِّ هذا، بل تلتفت إلى جاريتها لترى أنَّها رضيت بهذا العرس، ليس هذا فقط، بل يزداد الأمر غرابة حين يصل الخبر إلى الوالي حيث يشكو له علي بن الحسين÷.
فيقول أبو الفرج الأصفهاني: «فكره ذلك أهلها، وخاصموه إلى هشام بن إسماعيل([534])، فبعث إليها يخيّرها، فجاء إبراهيم بن عبد الرحمن من حيث تسمع كلامه، فقال لها: جُعِلت فداءك قد خيّرتك فاختاريني، فقالت: قلت ماذا بأبي، تهزأ بي؟ فعرف ذلك فانصرف، وخيَّروها، فقالت: لا أريده»([535]).
على الرغم من أنَّ هذه الرواية انفرد بها أبو الفرج الأصفهاني، وافتعل قصّة بعيدة كلَّ البعد عن هذه الأسرة الطاهرة، إلاّ أنَّ الرواية (تقول: قالت: لا أريده)، وهذا يعني لم يحصل زواج.
كما روى الزبير بن بكار عن عمِّه قال: «قالت سكينة لأمِّ أشعب: سمعت للناس خبراً؟ قالت: لا، فبعثت إلى إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.... وخيِّرت سكينة فأبت نكاح إبراهيم...»([536]).
هذه الروايات غير مقبولة؛ وذلك لأنَّ رواة الخبر هم الزبير بن بكار وعمُّه، وهم غير ثقات، واضطراب خبر الرواية؛ فمرّة أنَّها تزوَّجت بعد أن ولّته نفسها([537])، ومرّة لم يدخل بها([538])، ومرّة بقيت معه ثلاثة أشهر، ومرّة أبت النكاح([539])، كما يذكر ابن قتيبة الدينوري: «أنَّه كان قصيراً فلم ترضَ به، فخُلِعت منه، كما يذكر في موضوع آخر: أنَّه كان قصيراً ولم ترضَ بذلك بنو هاشم فخُلِعت منه»([540]).
وهذا الاضطراب يؤكِّد عدم وقوع الحادثة؛ لتناقضاتها الواضحة، وهناك دليل يؤكِّد بطلان الرواية؛ فقد ذُكر أنَّ إبراهيم خطبها بعد مقتل مصعب([541])، كما ذُكر كذلك أنَّ هشام بن عبد الملك فرَّق بينهما([542]).
لو رجعنا إلى تاريخ ولادة هشام بن عبد الملك لوجدنا قول الطبري في ذلك: «وُلد هشام بن عبد الملك عام قتل مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين، وأُمُّه عائشة بنت هشام ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد... وكانت حمقاء، أمرها أهلها ألاّ تكلّم عبد الملك حتّى تلد... وسار عبد الملك إلى مصعب فقتله، فلمّا قتله بلغه مولد هشام...»([543]).
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يخطب إبراهيم سكينة بعد مقتل مصعب ويفرِّق هشام بينهما وهو لا يزال طفلاً رضيعاً؟! كما أنَّ رفضه في بداية الأمر يدلُّ على عدم وجود كفاءة بين الطرفين، فكيف يتمُّ الزواج؟!
وإن صحّت هذه الرواية فمعناه أنّ سكينة تفكِّر في شخص قبل زواجها منه، فكيف تقبل الزواج من زيد بن عمرو (الزواج الرابع) وهي تعلم عدم وجود كفاءة؟ هذا ما يؤكِّد عدم مجازفة السيّدة سكينة بالزواج من أيٍّ من أولئك الأزواج.
كما أنّ زين العابدين× سار على نهج رسول الله محمد|، ونهج آبائه واتّبع سيرتهم في كلِّ شيء بما فيها المصاهرات، وقد حرص على أن لا يمسَّ بنات الرسالة سوء وهو على قيد الحياة.
ففي رواية أنَّ معاوية كتب إلى مروان عامله على الحجاز يأمره أن يخطب أُمَّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأبى عبد الله بن جعفر، فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إنَّ أمرها ليس إليَّ إنّما هو إلى سيدنا الحسين وهو خالها، فأخبر الحسين بذلك فقال: استخير الله تعالى، اللهمَّ وفِّق لهذه الجارية رضاك من محمّد، فلمّا اجتمع النّاس في مسجد رسول الله أقبل مروان حتّى جلس إلى الحسين، وقال: إنَّ أمير المؤمنين أمرني بذلك، وأن أجعل مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ، مع صلح ما بين هذين الحيّين مع قضاء دينه، وأعلم أنَّ من يغبطكم بيزيد أكثر ممن يغبطه بكم، والعجب كيف يستمهر يزيد وهو كفوُ مَن لا كفوَ له، وبوجهه يُستَسقى الغمام، إلى آخر كلامه. فقال الإمام الحسين×: الحمد لله الذي اختارنا لنفسه، وارتضانا لدينه، واصطفانا على خلقه، إلى آخر كلامه، ثمّ قال: يا مروان قد قلت فسمعنا، أمّا قولك مهرها حكم أبيها بالغاً ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنّة رسول الله في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو اثنتا عشرة أوقية يكون اربعمائة وثمانين درهماً، وأمّا قولك مع قضاء دين أبيها فمتى كان نساؤنا يقضين عنا ديوننا، وأمّا صلح ما بين هذين الحيين فإنا قوم عاديناكم في الله، ولم نكن نصالحكم للدنيا، ثم قال: اشهدوا جميعاً أنّي قد زوّجت أمَّ كلثوم بنت عبدالله بن جعفر من ابن عمِّها القاسم بن محمّد بن جعفر([544]).
هذا هو نهج أهل البيت^، فهل غاب عن الإمام السجاد× نهج جده| حينما قال: «بناتنا لبنينا، وبنونا لبناتنا»([545]).
هكذا التزم أهل البيت^ بكلام النبي|، ولم تتزوّج السيّدة سكينة غير ابن عمِّها عبد الله بن الحسن×([546]). ولو تتبّعنا قائمة ولد الإمام الحسن× لوجدنا أبا بكر والقاسم من نفس الأب والأُمِّ، وعبد الله بن الحسن أُمُّه بنت السليل، قتله حرملة ([547]).
وهذا الزواج تمَّ في عهد الإمام الحسين×.
ولقد كرّست السيّدة سكينة باقي حياتها لخدمة الدين، وكانت المرأة المثالية في عصرها، مبتعدة عن ملذات الدّنيا، محاربة الباطل، أحيت الشعائر الدينية والثورة الحسينية، فكان لها صدى واسع في المدينة؛ ممّا جعل التاريخ يصفها بأنّها أفضل نساء عصرها.
إنّ استهداف السيّدة سكينة هو في الحقيقة استهداف لخطِّ الأئمة، ومحاولة لإطفاء وهج النهضة الحسينية، وذلك من خلال تشويه الشخصيات التي لها دور بارز في إحياء نهضة كربلاء.
ثانياً: شبهات المجالس الأدبية
قبل الكلام عن هذه المجالس لابدّ أن نمهِّد له بحديث عن حال المجتمع، ولا سيما المجتمع في الحجاز (مكّة ـ المدينة) في العصر الأموي، ففي ذلك العصر دبَّ الفساد والتحلّل في المجتمع بسبب السياسة التي اتّبعها الأمويون في الحجاز، فكان لها تأثير كبير على إشاعة حياة الترف واللهو والغناء في مكّة والمدينة، فأُغدقت الأموال الطائلة على رجالات العرب في الحجاز؛ لإبعادهم عن السياسة وشؤون الحكم، فانصرفوا عنها إلى حياة ناعمة يهدّدها الغناء([548]).
لقد كان الحجاز أكبر مركز لظاهرتين متناقضتين، فهو أكبر مركز للحركة الدينية من دروس القرآن الكريم والحديث والفقه، يهرع إليه النّاس من جميع الأقطار، يأخذون عن رجاله علمَهم بالكتاب والسنة واستنباطهم الأحكام الشرعية، وفي الوقت نفسه هو أكبر مركز لحياة اللهو والعبث، ففيه أكبر المغنين والمغنيات؛ وذلك لأنَّ الحجاز فيه ارستقراطية العرب، وهم العنصر الفاتح، وقد نال هؤلاء خير الجواري وأرفعهنَّ نسباً وأكثرهن تأثّرا بالآداب غير الإسلامية، ومنهنَّ مَن تربىن ببيوت الملوك والأمراء، وتأدّبن بآداب الحضارة، فنقلن ذلك إلى الحجاز وصُبغ بالصبغة العربية، وهنَّ السبب في تأسيس مدرسة الغناء في الحجاز، بل في كلِّ بيت من بيوتهم، وضيّقوا على مَن عاداهم، وحجروا عليهم التفكير في الشؤون السياسية، وكان الشام هو العنصر المؤيّد لخلفاء بني أميّة، والفرق هو العنصر المعارض، فانصرف فتيان الحجاز بما لهم من مال وفير وجاه عزيز عن الإمارة والخلافة إلى اللهو([549]).
إنَّ كلَّ الأحداث السياسية أثّرت على نهضة الأدب العربي الإسلامي إلى أبعد غاية، فزجَّ الشعر الأُموي بنفسه في هذه الحياة المضطربة الصاخبة بالأحزاب والأهواء المتضاربة، واستمال الأمويون بالمال والعطاء كثيراً من الشعراء، وأشعلوا بينهم روح المنافسة، فأصبح الشعر في هذا العصر صناعة يتكسّب به بعض الشعراء([550]).
ومهما يكن من أمر فقد ساعد الأمويون على نشر الأدب، وعملوا على تعزيزه في صفته هذه، ونشّطوا أربابه بالمال الوافر وإذكاء العصبية والتنافس، فكان أدباً نشيطاً، إلاّ أنّه كان مستعبداً يخدم المصالح الحزبية والفردية، ويُلحق في أجواء الفن الطليقة ([551]).
وخاصّة لمّا صارت الدولة إلى آل مروان، وقام بها عبد الملك سنة 65هـ/684م، حيث غلب على الشعراء في أيامه، وتقرّبوا إليه بمدحه وطعن أعدائه من آل الزبير، أوالخوارج أو العلويين أو غيرهم([552]).
ومن هذا المنطلق عمل الأمويون على استمالة الشعراء والكتّاب بإعطائهم المال؛ من أجل مدحهم وإظهار فضائلهم ومناقبهم، وفي نفس الوقت الطعن بإعدائهم بشتّى الأساليب، وكان الشعر أحد أساليب النيل من معارضيهم.
وقد حاولوا النيل من آل بيت النبي|، فقد كُتب الكثير من الأبيات الشعرية، ونُسِبت بكلِّ بساطة لابنة مَن ضحَّى بدمه من أجل استقامة الدين؛ محاولة التشويه والتغطية على الثورة الحسينية، وبهدف أن يجعلوا بنات النبوّة متساويات مع بقية النساء الأمويات اللواتي تميّزن بزينتهنَّ وأشعارهنَّ، وتغزّل الشعراء بهنَّ، في الوقت الذي كانت المرأة الأموية تتمتع بحريّة، وكان المجتمع يتطوّر كثيراً عمّا كان عليه في عهد رسول الله| والخلفاء، وبسبب دخول العناصر الأجنبية الكثيرة، وشيوع الموسيقى والغناء، وكثرة الإختلاط بين الرجال والنساء([553]).
ولم تقتصر كتب التاريخ والأدب على وضع نصوص تتعلَّق بزواج سكينة من عدّة أشخاص، بل تعدّاه، وجعلوها ناقدة للشعراء، ومحبة للغناء والمزاح، وتسير في شوارع المدينة غير مراعية للحجاب.
والسؤال هو: لماذا السيّدة سكينة‘ بالذات تعرَّضت لمثل هذه التّهم وليس غيرها من العلويات؟
ترى الباحثة أنَّ الأمويين كانوا يطلعون على أحوال أهل البيت^ محاولة منهم للطعن بهم بكلِّ الأساليب، فعملوا على اضطهادهم وقتلهم وتشريد أتباعهم، وعملوا على وضع الأكاذيب على كلِّ ما يتعلّق بهم، وكانت السيّدة سكينة هي إحدى تلك المحاولات؛ لأنّ السيّدة سكينة‘ ـ بالذات ـ تميّزت بالجانب الأدبي الأصيل منذ صغر سنّها، ولهذا الأدب جذور، فإنَّ جدَّها علي بن أبي طالب÷ كان أبلغ العرب، كما أنَّ جدَّها امرأ القيس الذي يقول فيه الإمام علي×: «لو أنَّ الشعراء المتقدِّمين ضمَّهم زمان واحد، ونُصبت لهم راية فجروا معاً، علمنا من السابق منهم، وإذا لم يكن فالذي لم يقل لرغبة ولا لرهبة، قيل ومَن هو: فقال: الكندي ـ ويعني امرأ القيس ـ، قيل: ولِمَ؟ قال: لأنّي رأيته أحسنهم نادرة، وأسبقهم بادرة»([554]).
فلا نستبعد أن تكون السيّدة الرباب لقّنت ابنتها بعض الأشعار منذ صغرها، والدليل قصائد السيّدة سكينة ورثاؤها لأبيها في واقعة الطف، وكيف كانت تحمل تلك القصائد مدلولاً لغويّاً خالصاً، وكانت تلك القصائد دليلاً على قابليتها اللغويّة، وفصاحة لسانها وبلاغتها، كما لا ننسى أنَّها تربّت في بيوت تتلو القرآن ليلاً ونهاراً، فكانت أشعارها تحتلُّ الصدارة في المجتمع الأموي، فكيف يُظهر بنو أميّة تلك الأشعار التي ترثى بها سكينة، وتُوصف بها فاجعة كربلاء، وهم يريدون أن يخفوا جريمتهم؟ فاستخدموا أسلوباً آخر مستغلين فصاحتها الأدبية، فنسبوا كلَّ ما لا يليق بها إليها.
ففي العصر الأموي اشتركت النساء مع الرجال في الشعر، وظهر النقد واضحاً في الحجاز([555])، فاستغلّ العاملون براعة السيّدة سكينة الأدبية، والعصر المنحلَّ ومجتمعه المتحرِّر؛ لكي يكوِّنوا مجموعة من القصص والحكايات وملاحم الغزل وينسبونها إلى السيّدة سكينة‘.
إلاّ أنّنا نجد الإضطراب في نصوص هذه الأخبار، وهذا يبعث على عدم الإطمئنان بصحتها حسب الصورة التي نُقلت إلينا. وأقدم مصدر ينقل لنا هذه النصوص هو الأغاني، ومنهج صاحبه يقوم على جمع الروايات التي ينقلها الرواة والأخباريون قبل عصره، ومع ذلك فإنّ لهذا العمل الذي قام به الأصفهاني أهمية من حيث حفظ هذه المواريث الكثيرة، والتعليق عليها أحياناً([556]).
يذكر سزكين: أنّ أبو الفرج في هذا الكتاب ضمَّ مادة عدد كبير من الكتب، التي ضاع أكثرها ولم يصل إلينا من مادتها إلاّ ما أخذه أبو الفرج منه([557]).
يُضاف إلى ذلك أنَّ كثيراً ممّا تناقله أولئك الرواة والأخباريون يمتزج فيه التاريخ بالخرافة؛ لأنَّ الهدف منه تسلية السامعين أكثر ممّا هو تحري صحّة الخبر([558]).
وبعد هذا التمهيد نتحدّث الآن عن المجالس الأدبية، ومدى صحة ارتباط السيّدة سكينة بها:
1ـ مجلس عمر بن أبي ربيعة ([559])
يذكر أبو الفرج الأصفهاني: «أخبرني علي بن صالح قال: حدّثنا أبو هِفّان، عن إسحاق، عن أبي عبد الله الزبيري قال: اجتمع نسوة من أهل المدينة من أهل الشرف، فتذكّرنَ عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه وحسن حديثه، فتشوّقنَ إليه وتمنَّينَه، فقالت سكينة بنت الحسين: أنا لكنَّ به، فأرسلت إليه رسولاً وواعدته الصورين([560])، وسمَّت له الليلة والوقت، وواعدت صواحباتها، فوافاهنَّ عمر على راحلته، فحدّثهن حتّى أضاء الفجر وكان انصرافهنَّ، قال لهنَّ: والله إني لمحتاج إلى زيارة قبر رسول الله| والصلاة في مسجده، ولكنّي لا أخلط بزيارتكنَّ شيئاً، ثمّ انصرف إلى مكّة من مكانه، وقال في ذلك:
|
قالت سكينة والدموع ذوارفٌ |
وقبل الحديث عن هذه الرواية لابدّ أن نبيّن حال الرواة، بداية من علي بن صالح: يقول الذهبي: «قال ابن الجوزي: ضعَّفوه، قلت: لا أدري مَن هو»([562]).
أمّا أبو هِفّان: فيقول عنه الذهبي: «حدَّث عن الأصمعي بخبر منكر، قال ابن الجوزي: لا يُعوَّل عليه»([563]). وذكر ياقوت الحموي عنه: «كان ضيِّق الحال، متهتكاً، شرّاباً للنبيذ...»([564]).
وبما أنَّ رواة الخبر غير ثقات، وضعيفو الرواية؛ فلا يمكن أن نقبَل بهذه الرواية.
كما يرويها أبو الفرج الأصفهاني بطريقة أخرى في مواضع أخرى من كتابه، فيقول: «أجمع نسوة فذكرنَ عمر بن أبي ربيعه وشعره وظرفه ومجلسه وحديثه، فتشوَّقنَ إليه وتمنَّينه، فقالت سكينة: أنا لَكُنَّ به، فبعثت إليه رسولاً أن يوافي الصّورين ليلة سمَّتها، فوافاهنَّ على رواحله، فحدثهنَّ حتّى طلع الفجر، وحان انصرافهنَّ، فقال لهنَّ: والله إنّي لَمحتاج إلى زيارة قبر النبي والصلاة في مسجده، ولكنّي لا أخلط بزيارتكنَّ شيئاً، ثمّ انصرف إلى مكّة وقال ذلك:
|
ألمم بزينبَ إنَّ البَينَ قد أَفِدا لو جُمّع النّاس ثمّ اختِيرَ صفوُهُم |
ولا بدّ من الإشارة إلى أنَّ في روايات أبي الفرج الأصفهاني امرأتين تحملان اسم سكينة، هما: سكينة بنت الحسين÷، وسكينة بنت خالد بن مصعب([566]). فنلاحظ في الروايتين اختلافاً واضحاً جدّاً؛ ففي الرواية الأولى يذكر سكينة بنت الحسين÷، ويذكر القصيدة: (قالت سكينة والدموع ذوارف([567]))، بينما في الرواية الثانية يذكر فقط سكينة بدون بيان مَن تكون، ويذكر قصيدة: (ألمَّ بزينب إنَّ البين قد أفدا([568]))، وزينب هذه هي بنت موسى الجميحية ([569])، التي كان يتشبَّب بها عمر بن أبي ربيعة دائماً، ولقد ذكر فيها أبياتاً شعرية يقول فيها:
|
«يا
خليليَّ من ملامٍ دعاني |
ويقول عمر فيها أيضاً:
|
«طالَ من آل زينبَ الإعراضُ |
كما نجد القصيدة باسم امرأة أخرى تُدعى سُعدى بنت عبد الرحمن، فيذكر أبو الفرج الأصفهاني: «كانت سُعدى بنت عبد الرحمن بن عوف جالسة في المسجد الحرام فرأت عمر بن أبي ربيعة يطوف بالبيت، فأرسلت إليه إذا فرغت من طوافك فأتنا، فأتاها فقالت لا أراك يا بن أبي ربيعة إلاّ سادراً في حرم الله، أما تخاف الله؟ ويحك إلى متى هذا السفه؟ قال: أَيْ هذه، دعي عنكِ هذا من القول، أما سمعتِ ما قلتُ فيكِ؟ قالت: لا، فما قلت؟ فانشدها قوله:
|
قالتْ سعُيدِة والدموعُ ذوارف |
فقالت أخزاك الله يا فاسق، ما علم الله أنّي قلتُ ممّا قلتَ حرفاً، ولكنك إنسان بهوت هذا الشعر تغنّي فيه: قالت سكينة والدموع ذوارف. وفي موضع: أسعيد ما ماء الفرات وبرده أسكين. وإنّما غيّره المغنّون، ولفظ عمر ما ذُكر فيه في الخبر»([572]).
وهذا دليل واضح على التحريف، فيقول الفكيكي: «غيّره المغنّون، فجعلوا سكينة مكان سعيدة، وأسكين مكان أسعيد»([573]).
كما روي أنَّ إسحاق الموصلي([574]) غنّى هارون العباسي([575]) يوماً وقال:
|
قالت سكينة والدموعُ ذوارف |
فوضع هارون القدح من يده، وغضب غضباً شديداً وقال: لعنه الله الفاسق، ولعنك معه، فسقط في يدي، وعرف ما بي، فسكن ثمّ قال: ويحك أتغنيني بأحاديث الفاسق ابن أبي ربيعه في بنت عمي وبنت رسول الله؟! ألا تتحفّظ في غنائك وتدري ما يخرج من رأسك؟ عُد إلى غنائك الآن وانظر بين يديك، فيقول ابن إسحاق: فتركت هذا الصوت حتّى أنسيته فما سمعه منّي أحد([576]).
ولا أظنُّ أنَّ هارون استنكر هذا الصوت؛ لأنَّه مسَّ السيّدة سكينة‘، بل لأنَّ عمر بن أبي ربيعة كان دائماً يتعرّض لأخوات عبد الملك([577])، ويتّضح أنَّ اكتفاء هارون بذلك دون معاقبة إسحاق؛ راجع إلى إحاطته علماً بألاعيب الرواة ([578]).
كما نلاحظ أنَّ الرواة استغلّوا الوقت الذي زاحمت المرأة فيه الرجل، وأصبحت لا تختلف عنه في شيء([579])، هذا الوقت الذي تألَّق فيه الشعر وأصبح الأداة الفعّالة للدفاع عن الأحزاب التي نشأت في هذا العصر وقويت، وأهمّها: (العلوي ـ الأموي ـ الخوارج)، وكان لكلِّ حزب سياسة خاصّة([580]).
كما اختاروا عمر بن أبي ربيعة الذي تميّز بفسقه، فلم تعرض له حسناء قريشية أو غير قريشية إلاّ شبَّب بها وشهّر([581])، وكان يقضي أيّامه لاهياً مستمتعا، حتّى إذا أذن الموسم لبس الحلل الفاخرة، وخرج من مكّة يتلقّى الحاجّات المدنيات والعراقيات والشاميات، فيتعرّض لهنَّ ويتبعهنَّ إلى مناسك الحج، ولا يزال يترقّب خروجهنَّ للطواف في الكعبة حتّى ينظر إليهنَّ، ويرى منهنَّ ما لا يرى في خارج الحرم، فيصفهنَّ ويشهرهنَّ بشعره([582]).
وكان عمر بن أبي ربيعة معروفاً بالمجون والخلاعة، حتّى كانت النساء تخشى فسقه، وكانت تخرج ومعها محرم من أهلها. ومن أخباره: قدمت امرأة إلى مكّة، وكانت ذات جمال وعفاف، فأُعجب بها ابن أبي ربيعة، فأرسل إليها فخافت شعره، فلمّا أرادت الطواف قالت لأخيها: اخرج معي، فخرج معها وعرض لها عمر، فلمّا رأى أخاها أعرض عنها([583]).
وذكر ابن عبد ربه: «ما عُصى الله بشعر ما عُصي بشعر عمر بن أبي ربيعة»([584])، وقال شيخ من قريش: لا ترووا نساءكم شعر عمر بن أبي ربيعة؛ لئلا يتورطنَ في الزنا تورّطاً([585]).
وممّا تقدّم يتّضح سبب اختيارهم عمر بن أبي ربيعة ليكون بطل هذه الأكذوبة، ليستهدفوا به قداسة البيت العلوي.
ويذكر الحلو: «إنَّ محاولةَ الوضع باديةٌ عليه؛ إذ افتُتح الخبر بأنَّ نسوة من أهل المدينة من أهل الشرف اجتمعنَ، لم يتعرّض الخبر إلى ذكر واحدة منهنَّ، واختصّ بذكر سكينة بنت الحسين÷، وذلك دليل على أنَّ صياغة الخبر بهذه الطريقة قُصِد فيها التعرّض للسيّدة (آمنة) سكينة بنت الحسين÷ فقط، ورُتِّبت أحداثه لهذا الغرض، والخبر في صدد ذكر ظرافة عمر بن أبي ربيعة ومحاولاته العبثية، وهو ليس في صدد التعرُّض لسيرة أحد، هكذا يعطي الخبر مسحة البراءة على ما يفتعله الواضعون، محاولين من خلاله الترسّل لذكر وقائع أدبية صرفة، وليس الغرض التعرّض لسيرة أحد أو الإساءة للبيت العلوي الطاهر... على أنَّ اجتماع هذه النسوة من الليل حتّى طلوع الفجر يتنافى والحالة الاجتماعية التي تعيشها المدينة، فالالتزامات التي تعيشها المرأة في المدينة فضلاً عن تعفّفها عمّا يشين سمعتها لدى الآخرين تختلف كثيراً عن غيرها من الأنحاء الإسلامية، فالمدينة تجد من نفسها مصدر إشعاع إسلامي للسيرة النبوية، التي يمثّلها أهلها القاطنون وقتذاك، وهم لا يزالون يعتزّون بانتمائهم الإسلامي والتزامهم الديني، كما أنَّها لا تزال تحتفظ بقداستها النبوية»([586]).
والكلام أعلاه منطقي، ودليل ذلك ما قاله ابن قتيبة الدينوري: «وكان عمر فاسقاً يتعرّض للنساء والحواج... كان يشبّب بسكينة، وفيها يقول كذباً عليها: قالت سكينة والدموع ذوارف»([587]).
كما يقول القيرواني: «وفي سكينة يقول عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي كذباً عليها»([588]).
فتلك الرواية مدسوسة، نُقِلت عن القصّاصين والمغنين والرواة غير الثقات، الذين عاشوا على موائد البلاط الأموي.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ هناك مصادر سبقت أبا الفرج الأصفهاني في ذكر قصيدة: (قالت سكينة والدموع ذوارف)، إلاّ أنّهم لم يذكروا القصّة التي قصَّها أبو الفرج الأصفهاني في الصورين([589]).
لقد تميّز صاحب الأغاني ببراعة في وضع القصص والكثير من المفتريات، وخصوصاً على البيت الهاشمي، والظاهر أنَّ صاحب الأغاني أراد أن يبرّئ ساحة سكينة بنت خالد ممّا كانت عليه من الإستهتار والمجون، فوجد من اسم سكينة بنت الحسين÷ باباً واسعاً للتورية، وتضليل البسطاء، فنسب أفعال سكينة بنت خالد بن مصعب إلى سكينة بنت الحسين÷، وجاء بعد ذلك بعض المؤرخين والكتّاب فأخذوا عن أبي الفرج من دون أي انتباه([590]).
2ـ مجلس الشعراء
يزعم بعض رجال الأدب والتاريخ أنَّ السيّدة سكينة ناقدة أدبية، ونقدها يدور في مواجهة الشعراء أنفسهم، أو رواة شعرهم، ويكون المكان إمّا مجلس سكينة أو باب سكينة، والأبطال هم شعراء العصر الأموي؛ تسأل عن شيء من أشعارهم وتُعلِّق عليه بالإنتقاد أوتحكم عليه بالجودة، وتعطيهم جوائزها. وبعض الروايات تشير إلى أنّ سكينة تتحدّث مع الشعراء مباشرة، وبعضها تشير إلى قيام جارية بدور السفارة بين سكينة وبين الشعراء في نقل الشعر والتعليق عليه.
يذكر أبو الفرج الأصفهاني: «أخبرني الحسن بن علي قال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن مهروية قال: أخبرني عيسى بن إسماعيل، عن محمّد بن سلام، عن جرير المدين، عن المدائني، وأخبرني به محمّد بن أبي الأزهر... قالوا: اجتمع في ضيافة سكينة بنت الحسين جرير([591]) والفرزدق وكثير([592]) وجميل([593]) ونصيب([594])، فمكثوا أياماً، ثمّ أذِنت لهم فدخلوا عليها، فقعدت حيث تراهم ولا يرونها، وتسمع كلامهم، ثمّ أخرجت وصيفة لها وضيئة، وقد روت الأشعار والأحاديث، فقالت أيّكم الفرزدق؟... أيُّكم نصيب؟ فقال لها: هاأنذا، قالت: أأنت القائل:
|
ولولا أن يُقال صبا نصيبٌ |
قال: نعم، قالت: ربيتنا صغاراً ومدحتنا كباراً، خذ هذه الأربعة آلاف والحق بأهلك.
ثمّ دخلت على مولاتها وخرجت، فقالت: يا جميل مولاتي تقرئك السلام وتقول لك: والله وما زالت مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولك:
|
ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلة |
جعلتَ حديثنا بشاشة، وقتلانا شهداء، خُذ هذه الأربعة آلاف دينار والحق بأهلك»([595]).
قبل أن نبيّن اضطراب تلك الأشعار، لابدّ أن نوضِّح حال الرواة، فكلٌّ من محمّد ابن القاسم بن مهروية، وعيسى بن إسماعيل، وجرير المدني، ومحمد بن أبي الأزهر؛ غير معروفين، وقد أهملتهم كُتُب الرجال سوى محمّد بن سلام، فهم عديدون ولا نعرف مّن هو بالضبط([596]).
أمّا هذه الرواية فهي تتضارب مع غيرها مضمونا، حيث تذكر بعض المصادر: أنّه اجتمع بالمدينة راوية جرير، وراوية كثير، وراوية جميل، وراوية الأحوص([597])، فافتخر كلُّ واحد منهم بصاحبه، وقال صاحبي أشعر، فحكّموا سكينة بنت الحسين بن علي؛ لما يعرفونه من عقلها وبصرها بالشعر، فخرجوا ينقادون حتّى استأذنوا عليها فأذنت لهم، فذكروا لها الذي كان من أمرهم.
فقالت لراوية جرير: أليس صاحبك الذي يقول:
|
طرقتْكَ صائدة القلوبِ وليس ذا |
وأيُّ ساعة أحلى للزيارة من الطروق؟ قبّح الله صاحبك وقُبِّح شعره، ألا قال: فادخلي بسلام.
ثمّ قالت لراوية كثير: أليس صاحبك الذي يقول:
|
يقرُّ بعيني ما يقرُّ بعينِها |
فليس بشيء أقرُّ لعينها من النكاح، أفيحبُّ صاحبك أن يُنكح؟ قبّح الله صاحبك وقُبِّح شعره.
ثمّ قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول:
|
فلو تركتْ عقلي معي ما طلبتُها |
فما أرى صاحبك من هوى، إنّما يطلب عقله، قبّح الله صاحبك وقُبِّح شعره.
ثمّ قالت لراوية نصيب: أليس صاحبك الذي يقول:
|
أهيمُ بدعدٍ ما حَييتُ فإن أمُتْ |
فما أرى له همّة إلاّ مَن يتعشّقها بعده، قبَّحه الله وقُبِّح شعره، ألا قال:
|
أهيمُ بدعدٍ ما حَييتُ فإن أمُتْ |
ثم قالت لراوية الأحوص: أليس صاحبك الذي يقول:
|
من عاشِقَينِ تواعدا وتراسلا |
قال: نعم، قالت: قبّحه الله وقُبِّح شعره، ألا قال: تعانَقا. فلم تُثْنِ على أحد منهم([604]).
كما يضيف المرزباني([605]) بيتين على القصيدة التي مطلعها:
|
هما دلّتاني من ثمانينَ قامة |
والبيتان هما:
|
فأصبحت في القومِِ القعودِ وأصبحَتْ |
وهذا دليل على وضع الأكاذيب بصورة واضحة، كما أنَّ المعروف عن المرزباني أنَّ أكثر كتبه لم تكن سماعاً له، وإنَّما كان يرويها إجازة، قال ابن أيوب: سمعت أبا عبيد الله يقول: سوّدت عشرة آلاف، فصحَّ لي منها مبيَّضاً ثلاثة آلاف ورقة، ويقول أبو القاسم الأزهري: كان أبو عبيد الله يضع محبرته بين يديه وقنينته فيها نبيذ، فلا يزال يكتب ويشرب([608])، ومثل هؤلاء لا يمكن أخذ هذه الأخبار عنهم.
نلاحظ الرواية بشكل مختلف تماماً عند السراج القاري([609])، حيث يقول: حدّثنا الأصمعي عبد الملك بن قريب، عن أبيه عن لبطة بن الفرزدق بن غالب، قال: اجتمع أبي وجميل بن معمر العذري، وجرير بن الخطفى، ونصيب مولى عمر، وكثير في موسم من المواسم، فقال بعضهم لبعض: والله لقد اجتمعنا في هذا الموسم لأمر خير أو شر، وما ينبغي لنا أن نتفرَّق إلاّ وقد تتابع لنا في النّاس شيء نُذكَر به، فقال جرير: هل لكم في سكينة بنت الحسين÷ بن علي بن أبي طالب، نقصدها فنسلِّم عليها، فلعلَّ ذلك يكون سبباً لبعض ما نريد؟ فقالوا: امضوا بنا، فمضينا إلى منزلها، فقرعنا الباب، فخرجت إلينا جارية لها بريعة طريفة، فأقرأها كلُّ رجل منهم السلام باسمه ونسبه، فدخلت الجارية وعادت فبلغتهم سلامها، ثمّ قالت: أيّكم الذي يقول:
|
سَرَتِ الهمومُ فبتْنَ غيرَ نيام |
قال جرير: أنا قائله، قالت: فما أحسنت ولا أجملت، ولا صنعت صنيع الحرّ الكريم، لا ستر الله عليك كما هتكت سترك وسترها، ما أنت بكلف ولا شريف حين رددتها بعد هدوء العين، وقد تجشّمتْ إليك هول الليل، ثم قالت له: خذ هذه الخمسمائة درهم، فاستعن بها في سفرك، ثمّ انصرفت إلى مولاتها وقد أفحمتنا، وكلّ واحد من الباقين يتوقّع ما يخجله.
ثمّ خرجت فقالت: أيّكم الذي يقول:
|
ألا حبَّذا البيتُ الذي أنا هاجرُه |
فقال أبي، يعني الفرزدق: أنا قلته، قالت: ما وُفِّقت ولا أصبت، أما أيّست بتعريضك من عودة عندك محمودة؟! خذ هذه الستمائة فاستعن بها، ثمّ انصرفت إلى مولاتها.
ثمّ عادت فقالت: أيّكم الذي يقول:
|
فلولا أن يُقالَ صبا نصيبٌ |
فقال نصيب: أنا قائله، فقالت: أغزلت وأحسنت وكرمت، إلاّ أنَّك صبوت إلى الصغار، وتركت الناهضات بأحمالهن، خذ هذه السبعمائة درهم فاستعن بها، ثمّ انصرفت إلى مولاتها.
ثمّ عادت فقالت: أيّكم الذي يقول:
|
وأعجبني يا عزُّ منكِ خلائقٌ لديكِ فلم يوجدْ لكِ الدهرَ مطمعُ([613]). |
قال كثير: أنا قلته، قالت: أغزلت وأحسنت، خُذ هذه الثمانمائة درهم فاستعن بها.
ثم وصل الدور إلى شعر جميل (لكل حديث بينهن بشاشة)، فقالت له: أغزلت وكرمت وعطفت، أدخل، قال: فلمّا دخلتُ سلّمتُ، فقالت لي سكينة: أنت الذي جعلت قتيلنا شهيداً، وحديثنا بشاشة، وأفضل أيامك يوم تنوب فيه عنّا، وتدافع ولم تتعدّ ذلك إلى قبيح، خذ هذه الألف درهم، وابسط لنا العُذر، أنت أشعرهم([614]).
وجاء في خبر آخر: فقالت: أيّكم الفرزدق؟ فقال لها: هأنذا، فقالت: أنت القائل:
|
هما دلّتاني من ثمانينَ قامة |
قال: نعم، قالت: فما دعاك إلى إفشاء سرِّها وسرِّك، هلّا سترتها وسترت نفسك؟ خذ هذه الألف والحق بأهلك.
ثمّ دخلت على مولاتها وخرجت، فقالت: أيّكم جرير؟ فقال لها: هأنذا، فقالت: أنت القائل:
|
طرقتْكَ صائدة القلوبِ وليس ذا |
قال نعم، فقالت: أفلا أخذت بيدها، ورحَّبت بها، وقلت لها ما يقال لمثلها، أنت عفيف وفيك ضعف، خذ هذه الألف والحق بأهلك.
ثمّ دخلت على مولاتها وخرجت، فقالت: أيكم كثير؟ فقال: هأنذا، فقالت: أنت القائل:
|
وأعجبني يا عزُّ منكِ خلائق |
كما يذكر ابن عساكر الرواية من غير نصيب فيقول: «... ببابها الفرزدق، وجرير وكثير، وعزة، وجميل...»([618]).
ونلاحظ نقصان الأبيات الشعرية عند ابن الجوزي([619])، هكذا نجد اختلافاً واضطراباً واضحاً في بعض أسماء الشعراء، وبعض نصوص الشعر؛ إذ نجد فيها ذكر الأحوص ونصيب، ولا نجد ذكراً للفرزدق، وتختفي منها الأبيات السابقة لجميل وكثير، وترد أبيات غيرها لهما، كما يختلف فيها إطار القصّة قليلاً، فرواة الشعراء هم الذين يجتمعون عند سكينة ويحتكمون إليها، وليس الشعراء أنفسهم، وسكينة هنا تخاطب الرواة مباشرة دون وساطة وصيفة، ويدور هذا النصُّ على انتقاد جميع الشعراء في الأبيات الغزلية التي ترد لهم دون تمييز أحد على أحد. والغرض من عرض الروايات بالتفصيل بيان ذلك الإضطراب.
كما أنَّ هناك مسألة مهمّة تؤكِّد عدم صحّة هذا الخبر؛ وهو اجتماع الفرزدق وجرير وهو غير ممكن؛ لظروف الهجاء والتفاخر الذي شاع بينهما، فالنفرة التي كانت بين الشاعرين تأبى التوفيق بينهما على باب واحد، فيذكر ياقوت الحموي: «حدّث أبو عبدالله محمّد بن سلام الجمحي، فسمعت يونس بن حبيب يقول: ما شهدت مشهداً قطُّ ذُكِر فيه جرير والفرزدق وأجمع أهل المجلس على أحدهما»([620]).
كما اشتهر أغلب الشعراء بأخذ العطاء من الخلفاء الأمويين، فهل يقبلون عطاء سكينة ؟! فجرير مدح يزيد بن معاوية ([621]).
وكثير كان متكبِّراً، وكان شاعر بني مروان، وخاصة عبد الملك، وكانوا يعظِّمونه ويكرمونه([622]).
أمّا نُصيب فهو مولى عبد العزيز بن مروان([623])، فهل يُعقل أنّ مثل هؤلاء يتنافسون على باب سكينة ويأخذون المال منها؟!
كما أنَّ الرواية بأكملها منافية للشريعة الإسلامية، قولهم أنَّها قابلتهم من وراء ستار، تراهم ولا يرونها وتسمع كلامهم([624]). فهذا سلوك يتناقض مع قوله تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ)([625]). ويتناقض أيضاً مع مضمون أحاديث الرسول الأعظم|، التي تشير إلى الحجاب وغضِّ البصر، كقوله لأمِّ سلمة وزينب حين دخل ابن أُمّ مكتوم: قوما فاحتجبا، فقلت:... إنّه أعمى لايبصرنا، قال: فإن كان لا يبصركنّ فإنكنّ تبصرْنَه([626]).
وأمّا قوله (ثم خرجت وصيفة لها وضيئة)، فأيضا فيه تناقض؛ إذ لا يصحُّ أن تكلِّف سكينة إحدى ربيباتها لتقابل مجموعة من الشعراء وجهاً لوجه، وهي كما وصفها الراوي وضيئة؛ أي جميلة ملفتة للنظر. ثمّ أيصحُّ أن ترتضي سكينة لنفسها الحجاب وتضع حاجزاً كي لا يراها الشعراء وتبيح السفور لغيرها؟!
كما أنَّ هذه الروايات تدلُّ على أنّ السيّدة سكينة لم ترتبط بأيِّ زوج، فلو كان لها زوج كما زعمت المصادر، فكيف يُسمح لعمر بن أبي ربيعة أن يقول شعراً بحقِّ سكينة؟! وكيف يُسمح للشعراء بالانتظار على بابها؟!
ومن خلال نظرة سريعة لهاتين الروايتين يتّضح وجود الكثير من الإشكالات عليها، فهنالك تلاعب بالألفاظ، وتناقض بالحكم، فمرّة ضعيف وعفيف وإكرامه بألف دينار، وأخرى قبَّحه الله وقُبِّح شعره، والشعر نفسه لم يتغيّر، كما يتّضح لنا أنَّ قصّة اجتماع الشعراء عند سكينة لم يذكرها ابن قتيبة الدينوري، ولا ابن طيفور، كما نجد الشعر في بقية المصادر ولم تذكر القصّة أيضاً.
كما نلاحظ أنَّ الشعراء ورواتهم يتحدَّثون بسوء أدب، ومثل هكذا شعر (غزلي) لا يليق أن تسمعه نساء عاديات في مدينة الرسول| فكيف لو كانت ابنة الرسول نفسه؟!
كما نلاحظ أنَّ ورود نفس هذه الرواية ولكن في محضر الخليفة عبد الملك، يذكر المبرّد: «حدّثت أنّ جريراً كان يقول: وددت أنّ هذا البيت من شعري... وأما قول نصيب:
|
أهيم بدعدٍ ما حييتُ وإن أمتْ |
... فقال عبد الملك: ما قلت والله أسوأ ممّا قاله...»([627]).
فهنا عبد الملك هو الذي ينقد الشعراء ويعطي المال، فلا أستبعد قيام الوضّاعين بتغيير اسمه، وجعل سكينة بدلهُ.
أ ـ سكينة والفرزدق
ذُكِر في خبر أنّ الفرزدق خرج حاجاً فمرَّ بالمدينة، ودخل على سكينة بنت الحسين÷ بن علي بن ابي طالب مسلِّماً عليها، فقالت: يا فرزدق مَن أشعر النّاس؟ قال: انا، قالت: أشعر منك الذي يقول:
|
بنـفسي مَن تجنِّيهِ عزيزٌ |
قال: والله لئن أذِنتِ لي لأسمعتُكِ أحسنَ منه، قالت: أقيموه فأخرج، ثمّ عاد إليها من الغد فدخل عليها، فقالت: يا فرزدق مَن أشعر النّاس؟ قال: أنا، قالت: كذبت، صاحبك أشعر منك حيث يقول:
|
لولا الحياءُ لَعادني استعبارُ |
فقال والله لئن أذِنتِ لي لأسمعتكِ أحسنَ منه، فأمرت به فأُخرج، ثمّ عاد إليها في اليوم الثالث، وحولها مولّدات كأنهنَّ التماثيل، فنظر الفرزدق إلى واحدة منهنَّ فأُعجب بها، فقالت: يا فرزدق مَن أشعر النّاس؟ فقال: أنا، فقالت: كذبت، صاحبك أشعر منك حيث يقول:
|
إنَّ العيونَ التي في طرفِها مرضٌ |
فقال الفرزدق: يا بنت رسول الله إنَّ لي عليك حقّاً عظيماً، ضربتُ إليك من مكّة أريد التسليم عليك، فكان في دخولي إليك تكذيبي، ومنك إياي أن أسمعك وبي ما قد عِيل معه صبري، وهذه المنايا تغدو وتروح، ولعلّي لا أفارق المدينة حتّى أموت، فإن أنا متُّ فمُرِي أن أُدرَج في كفني، وأُدفن في حَرِ تلك الجارية، يعني الجارية التي أعجبته، فضحكت سكينة، وأمرت له بالجارية، فخرج بها آخذاً بريطتها، وأمرت الجواري أن يدفقن في أقفائهما، ثمّ قالت: يا فرزدق أحسِن صحبتها فإنّي آثرتك بها على نفسي([631]).
أمّا سراج القاري فيقول: «قال يا ابنة رسول الله إنّ لي عليك حقاً عظيماً لموالاتي لكِ ولآبائك، إنّي سِرتُ إليك من مكّة قاصداً لكِ؛ إرادة التسليم عليك، فلقيت في مدخلي إليك من التكذيب والتعنيف، ومنعك إياي أن أُسمِعَكِ من شعري ما قطع ظهري، وعِيل صبري به، والمنايا تغدو وتروح، ولا أدري لعلّي لا أفارق المدينة حتّى أموت، فإذا متُّ فمُري مَن يدفنني في درع هذه الجارية، وأومأ إلى الجارية التي كلف بها، فضحكت سكينة حتّى كادت تخرج من بردها، ثمّ أمرت له بألف درهم وكساء وطيب، وبالجارية بجميع آلتها، وقالت: يا أبا فراس: إنمّا أنت واحد منّا أهل البيت لا يسوؤك ما جرى، خذ ما أمرنا لك به، بارك الله لك فيه، وأحسن إلى الجارية، وأكرم صحبتها، وأمرت الجواري فدفعنَ في ظهورهما، فقال الفرزدق: فلم أزل والله أرى البركة بدعائها في نفسي وأهلي ومالي»([632]).
كما نلاحظ الرواية نفسها عند أبي الفرج ولكن بشكل مختلف([633])، وعلى الرغم من اختلاف الروايات إلاّ أنَّ المغزى من الروايات المختلفة واحد، فسكينة تفضِّل جرير على الفرزدق، ويُعجب الفرزدق بإحدى الجواري، وتهب سكينة تلك الجارية للفرزدق.
هذا الكلام غير منطقي، فقد ذكرت المصادر أنّ الفرزدق كان مواليا لأهل البيت^، وكان يخفي ذلك؛ خوفاً من بني أميّة. ولقد رُوي أنَّ هشام بن عبد الملك حجَّ في ولاية أبيه فطاف بالبيت، وأراد أن يستلم الحجر فلم يقدر عليه من ازدحام النّاس عليه، فنُصِب له منبر فجلس عليه، وبينما هو كذلك أقبل زين العابدين، فجعل يطوف بالبيت، فلمّا بلغ الحجر تنحّى النّاس عنه حتّى يستلمه هيبة له وإجلالاً، فغاظ ذلك هشاماً، وسُئِل عنه فتجاهله؛ فانتفض الفرزدق قائلاً:
|
هذا الذي تعرفُ البطحاءُ وطأتَه |
فغضب هشام، وأمر بحبس الفرزدق، وقال: والله لأحرمنَّه العطاء، فأرسل إليه علي بن الحسين÷ اثني عشر ألف درهم، فأبى الفرزدق أخذ الأجر أو التعويض عمّا ناله بسبب مدحه للإمام، فقال له: بحقّي عليك إلا قبلتها، فقد رأى الله مكانك وعلم نيتك وشكر لك فعلك، ونحن أهل البيت إذا أنفذنا شيئاً لايرجع إلينا([635]).
وهذا دليل على احترام وموالاة الفرزدق لأهل البيت^، وما تقدّم من تلك الأخبار ما هي إلّا محاولة لتشويه سيرة كلٍّ من الفرزدق والسيّدة سكينة؛ لكي يطعنوا بسيرة أهل البيت^ ومحبيهم، ويجعلوا سيرة خلفاء بني أميّة هي الأفضل.
ب ـ السيّدة سكينة وعروة بن أذينة ([636])
لقد رُوي أنَّ سكينة بنت الحسين بن علي^ وقفت على عروة بن أذينة، ومعها جواريها، فقالت: يا أبا عامر أنت الذي تزعم أنّ لك مروءة، وأنّ غزلك من وراء عفّة وأنّك تقيّ؟ قال: نعم، قالت أفأنت الذي تقول:
|
قالت وأبثثتها وجدي فبُحتُ به |
قال لها: بلى، قالت: هنَّ حرائر إن كان هذا خرج من قلب سليم، أو قالت: من قلب صحيح([638]).
|
اذا وجدتُ أوارالحبَّ في كبدي |
إنَّ كلَّ مَن يتتبّع كتب الأدب سيلاحظ التضارب بين المصادر في نقل هذا المعنى، حيث ذكرت بعض المصادر الأخرى أنَّ امرأة وقفت على عروة وقالت له: أنت الذي يُقال فيك الرجل الصالح، وأنت تقول:
وفي مصادر أخرى أيضا ذكرت: «مرَّت سكينة بعروة بن أذينة»([640])، من غير أن تذكر شخصها، مستغلّين لقب السيّدة؛ ليجعلوا منها أداة لتشويه الحقائق، كما نلاحظ أبا الفرج الأصفهاني يستغلّ لقب السيّدة فيقول مرّة: مرّت امرأة بابن أذينة وهو بفناء داره، وفي موضع آخر من كتابه يجعل السيّدة سكينة هي تلك المرأة([641]).
ثالثاً: شُبُهات الغناء
لقد عُرف الحجاز بالغناء، وعُنِي به عناية بالغة في العصر الأموي، فقد طلبه أشرافه واهتمُّوا به اهتماماً شديداً، وأوّل مَن اتخذ الغناء والمغنّين من بني أميّة: يزيد بن معاوية، فقد طلبهم من المدينة، وذهب إليه سائب خاثر([642])، وأخذت مهنة الغناء تظهر في عنصر الرجال من الموالي([643]).
كما أنَّ يزيد بن معاوية أوّل مَن سنَّ الملاهي واستجلب المغنّين إلى الشام، فجعل يقيم الحفلات الكبرى في بلاطه، ومن ثمّ أصبح الغناء والشرب صنفين متآلفين في تاريخ الدولة الإسلامية، واستمرَّ الخلفاء من بعده على نفس المنهج، ففي عهد بني أميّة ازدهرت الموسيقى في الحجاز، لدرجة كان حبُّ الغناء قد سرى في نفوس خاصّتها وعامّتها([644]).
لقد شهد العصر الأموي انحلالاً خلقيّاً وتدنيّاً على المستوى الديني، فتميّزت المرأة الأمويّة بمخالطة الرجال، وأصبحت أكثر تحرّراً من ذي قبل، فنلاحظ نتيجة تلك المخالطات تشبُّب الشعراء بهنّ([645]).
لقد أخذ رجال التاريخ يتكلّمون عن السيّدة سكينة‘، جاعليها كواحدة من تلك النساء الأمويّات، والغرض من إيراد هكذا روايات؛ هو حجب الجانب الديني للأسرة العلويّة، فكانت نساء الأمويّين مشتهرات بمخالطة الرجال، وبدأ الفسق ينتشر والأخلاق تنحلُّ، وجعلت من مدينة النبي| مكان طرب وغناء، بينما نجد العكس عند أبناء النبي|، وبالتالي عمدوا الى وضع الأكاذيب؛ ليجعلوهم والمجتمع الأموي سواسية، وكانت سيرة السيّدة سكينة‘ هي الأكثر تعرّضاً للتشويه؛ وذلك لما كانت تتميّز به من عبادة وتقوى، والرواية لأحداث الطف، لدرجة أنّها لم تتزوّج، بل انقطعت لكي تُحيي ـ إلى جانب الأئمة الأطهار ـ كلّ ما أُميت من الدين، فعمد الأمويّون بأساليبهم وأكاذيبهم إلى التغطية على كلِّ ما قامت به السيّدة سكينة.
ونموذج آخر من الأكاذيب ما قاله أبو الفرج الأصفهاني: «حدّثني
عبد الله بن
أبي سعد قال: حدّثني حسان بن محمّد الحرثي، قال: حدّثنا عبد الله قال: حدّثنا عبيد
بن حنين الحيري قال: كان المغنّون في عصر جدِّي أربعة نفر: ثلاثة في
الحجاز وهو وحده بالعراق، والذين بالحجاز ابن سريج([646])والغريض([647]) ومعبد([648])، فكان يبلغهم أنّ جدّي حنيناً([649]) قد غنّى في هذا الشعر:
|
هلّا بكيتَ على الشَّبابِ الذاهب |
فاجتمعوا فتذاكروا أمر جدّي، وقالوا ما في الدّنيا أهل صناعة شرٌّ منا، لنا أخ بالعراق ونحن بالحجاز لا نزوره ولا نستزيره، فكتبوا إليه ووجّهوا إليه نفقة، وكتبوا يقولون: نحن ثلاثة وأنت وحدك فأنت أولى بزيارتنا، فشخص إليهم، فلمّا كان على مرحلة من المدينة بلغهم خبره، فخرجوا يتلقّونه، فلم يُرَ يوم كان أكثر حشراً ولا جمعاً من يومئذ، ودخلوا، فلمّا صاروا في بعض الطريق قال له معبد: صيروا إليّ، فقال له ابن سريج: إن كان لك من الشرف والمروءة مثل ما لمولاتي سكينة بنت الحسين÷ عطفنا إليك؟ فقال ما لي من ذلك شيء، وعدلوا إلى منزل سكينة، فلمّا دخلوا إليها أذنت للناس إذناً عاماً، فغصّت الدار بهم وصعدوا فوق السطح، وأمرت لهم بالأطعمة فأكلوا منها، ثمّ إنّهم سألوا جدّي حنيناً أن يغني. فازدحم النّاس على السطح وكثروا ليسمعوه فسقط الرواق على مَن تحته، فسلموا جميعاً وخرجوا أصحّاء، ومات حنين تحت الهدم، فقالت سكينة‘: لقد كدّر علينا حنين سرورنا، انتظرناه مدّة طويلة كأنّا والله نسوقه إلى منيته([651]).
نجد في هذه الرواية أنّ السيّدة سكينة تدعو الجميع لحضور غناء حنين (والدعوة عامة)، لدرجة يسقط سقف المنزل على رأس حنين، ولو راجعنا كتب التاريخ والأدب لم نعثر على تاريخ محدّد لوفاة حنين المغنّي سوى النويري([652]) الذي يقول: عاش مائة سنة وسبع سنين، أي تُوفي سنة 110هـ/728 م([653])، فلو صحَّ هذا التاريخ يعني في سنة 110هـ/728م سقط عليه سقف ومات، فكيف شهِدَ ابن سريج المتوفَّى سنة 98هـ/ 716م، والغريض المتوفَّى سنة 95هـ/713م حادثة وفاة حنين سنة 110هـ/ 728 م وهم توفوا قبل هذا التاريخ بخمس عشرة سنة؟!
لقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني: «أن ابن سريج كان نائحاً، ثمّ أصبح مغنيّاً بعد ذلك، حيث ذكر أنّ سكينة بنت الحسين بعثت إلى ابن سريج بشعر، أمرته أن يصوغ فيه لحناً يُناح به..
|
يا أرضُ ويحكِ أكرمي أمواتي |
فقدّمه ذلك عند أهل الحرمين على جميع ناحة المدينة والطائف... إنّ سكينة بعثت إليه بمملوك لها يُقال له: عبد الملك، وأمرته أن يعلّمه النياحة، فلم يزل يعلّمه مدّة طويلة، ثمّ تُوفِّي عمُّها أبو القاسم محمّد بن الحنفية، وكان ابن سريج عليلاً علّة صعبة فلم يقدر على النياحة، فقال لها عبدها عبد الملك: أنا أنوح لكِ أنسيكِ به نوح ابن السريج، قالت: أو تحسِن ذلك؟ قال: نعم، فأمرته فناح، فكان نوحه في الغاية من الجودة، وقال النساء: هذا نوح غريض؛ فلُقِّب عبد الملك الغريض، وأفاق ابن سريج من علّته بعد أيام وعرف خبر وفاة ابن الحنفية، فقال لهم: فمَن ناح عليه؟قالوا: عبد الملك غلام سكينة، قال: فهل جوز النّاس نوحه؟قالوا: نعم وقدمه بعضهم عليك، فحلف ابن سريج ألاّ ينوح بعد ذلك اليوم، وترك النوح وعدل إلى الغناء، فلم ينح حتّى ماتت حبابة، وكانت قد أخذت عنه وأحسنت إليه، فناح عليها ثمّ ناح بعدها على يزيد بن عبد الملك، ثمّ لم ينح بعده حتّى هلك»([654]).
لا يمكن أن تُقبل هذه الرواية؛ وذلك بسبب التفاوت الزمني، فإنّ هذه الرواية تدلّ على أنّها وقعت بعد وفاة محمّد بن الحنفية المتوفَّى سنة 81هـ/700م([655])، فلو رجعنا إلى تاريخ وفاة الغريض فهو 95هـ/713 م([656])، وابن سريج 98هـ/716م([657]).
كما أنّ مضمون الرواية يقول ترك النياح وأبدله بالغناء، ولم ينح حتّى ماتت حبابة... ثمّ ناح بعدها على يزيد بن عبد الملك، ومن المعروف أنّ يزيد بن عبد الملك تُوفي في نفس العام الذي توفيت فيه حبابة سنة 105هـ/723 م([658])، وعليه كيف يمكن لابن سريج المتوفَّى سنة 95هـ/713م أن يحضر وفاة يزيد وحبابة سنة 105 هـ/ 723م، وينوح عليهما؟!
ثمّ ما السبب الذي يجعل سكينة من دون أسرتها تجلب نائحا لها، ثمّ تستبدله بآخر؟! كما أنّه لو صحّت هذه الرواية لدلَّت على أنّ السيّدة سكينة كان حزنها على ذويها واضحاً في المدينة، فكيف تسمح لمغنّين أربعة أن يغنّوا في داخل منزلها، وهي وأسرتها تحاصرها الأحزان في كلِّ الأوقات؟!
كما يذكر أبو الفرج الأصفهاني قال: «أخبرني الحسين بن يحيى، عن حمّاد، عن أبيه، عن مصعب الزبيري قال: حدّثني شيخ من المكيّين قال: كان ابن سريج قد أصابته الريح الخبيثة وآلى يميناً ألاّ يغنّي، ونسك ولزم المسجد الحرام حتّى عُوفي، ثمّ خرج وفيه بقيّة من العلّة، فأتى قبر النبي وموضع الصلاة، فلمّا قدِم المدينة نزل على بعض إخوانه من أهل النسك والقراءة، فكان أهل الغناء يأتونه مسلّمين عليه فلا يأذن لهم بالجلوس والمحادثة، فأقام بالمدينة حولاً حتّى لم يحسّ علّته بشيء وأراد الشخوص إلى مكّة، وبلغ ذلك سكينة بنت الحسين فاغتمّت اغتماماً شديداً، وضاقت به ذرعاً، وكان أشعب يخدمها، وكانت تأنس بمضاحكته ونوادره، وقالت لأشعب: ويلك إنّ ابن سريج شاخص، وقد دخل المدينة منذ حول ولم أسمع غناءه قليلاً ولا كثيراً، ويعزّ ذلك عليَّ، فكيف الحيلة إلى الإستماع منه ولو صوتاً واحداً؟ فقال لها أشعب: جُعِلتُ فداكِ وأنّى لكِ ذلك والرجل اليوم زاهد ولا حيلة فيه؟ فارفعي طمعك والحسي تورك تنفعك حلاوة فمك، فأمرت بعض جواريها فوطئنَ بطنه حتّى كادت تخرج أمعاؤه، وخنقته حتّى كادت نفسه أن تُتلف، ثمّ أمرت به فسُحِب على وجهه حتّى أُخرج من الدار إخراجاً عنيفاً، فخرج على أسوإِ الحالات، واغتمّ أشعب غمّاً شديداً، وندم على ممازحتها في وقت لم ينبغِ له ذلك، فأتى منزل ابن سريج ليلاً فطرقه، فقيل: من هذا؟ فقال: أشعب، ففتحوا له، فرأى على وجهه ولحيته التراب والدم سائلاً من أنفه وجبهته على لحيته، وثيابه ممزّقة، وبطنه وصدره وحلقه قد عصرها الدوس والخنق وبات الدم فيها، فنظر ابن سريج إلى منظر فظيع هاله وراعه، فقال له: ما هذا ويحك؟ فقصَّ عليه القصّة... قال أشعب: فديتُكَ هي مولاتي ولابدّ لي منها، ولكن هل لكَ حيلة في أن تصير إليها وتغنِّيها فيكون ذلك سبباً لرضاها عنّي؟ قال ابن سريج: كلا والله لا يكون ذلك أبداً بعد أن تركتُه، قال أشعب: قطعت أملي ورفعت رزقي وتركتني حيران بالمدينة لا يقبلني أحد، وهي ساخطة عليَّ، فالله الله فيَّ، أنا أنشدك الله إلاّ تحمّلت هذا الإثم فيَّ؛ فأبى عليه، فلمّا رأى أشعب أنَّ عزم ابن سريج قد تمَّ على الإمتناع قال في نفسه: لا حيلة لي وهذا خارج وإن خرج هلكت، فصرخ صرخة آذن أهل المدينة لها، ونبّه الجيران...، فلمّا رأى ابن سريج الجدّ منه قال لصاحبه: ويحك أما ترى ما وقعنا فيه، وكان صاحبه الذي نزل عنده ناسكاً فقال: لا أدري ما أقول فيما نزل بنا من هذا الخبيث...، فقال امضِ لا بارك الله فيك، فمضى معه، فلمّا صار إلى باب سكينة قرع الباب، فقيل: من هذا؟ فقال أشعب...، ثمّ اندفع يغنّي:
|
أستعين الذي يكفيه نفعي |
|
ورجائي على التي قتلتني([659]).
|
فقالت له سكينة: فهل عندك يا عبيد من صبر؟ ثمّ أخرجت دُملجاً من ذهب كان في عضدها وزنه أربعون مثقالاً، فرمت به إليه...»([660]).
رُوي هذا الخبر عن طريق مصعب بن الزبير، وقد عرفنا عداءه لأهل البيت، عن شيخ من المكيّين الذي لا يُعرف مَن هو، أمّا الحسين بن يحيى «قال ابن الجوزي: وضع حديثاً»([661]).
وفي رواية أخرى يرويها الزبير بن بكار قال: إنَّ سكينة بنت الحسين÷ حجَّت فدخل عليها ابن سريج والغريض، وقد استعار ابن سريج حلّة لامرأة من قريش فلبسها وقال: سيدتي إنّي كنت وضعت صوتاً وحسّنته وتنوّقتُ فيه، وخبّأته لكِ في حريرة في درج مملوء مسكاً فنازعنيه هذا الفاسق ـ يعني الغريض ـ فأردنا أن نتحاكم إليك فيه، فأيّنا قدَّمتِه فيه تقدّم، قالت هاتِه فغنّاها:
|
عُوجي علينا ربَّة الهودجِ |
فقالت لابن سريج أعده فأعاده، وقالت يا غريض أعده فأعاده، فقالت: ما أشبِّهكما إلاّ بالجديين الحار والبارد لا يُدرى أيهما أطيب، وقال إسحاق في خبره: ما أشبِّهكما إلاّ باللؤلؤ والياقوت في أعناق الجواري الحسان لا يُدرى أيُّهما أحسن([663]).
على الرغم من أنَّ راوي هذه الرواية هو الزبير بن بكار المعروف بعدائه لأهل البيت، إلاّ أنَّ كلَّ ما قيل في حقِّ السيّدة سكينة من أنّها تسمع الغناء، أو تحكم في جودة الأصوات، أو تسمح للمغنّين في الدخول إلى منزلها؛ هذا كلام منسوب إليها، وليس من فعلها.
ولا ننسى أنّ الغناء محرّم، جاء تحريمه في الإسلام على لسان النبي|، وهناك ثمَّة آيات عديدة ومتضافرة تدلّ دلالة واضحة على حرمة الغناء والموسيقى، وقد أشار إلى ذلك المفسرون، نذكر آيتين على سبيل التمثيل لا الحصر:
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) ([664])
تعني من يستبدل اللهو والغناء والمزامير والمعارف بالقرآن، وقد سُئل ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء والذي لا إله إلاّ هو يرددها ثلاث مرات([665]).
وقوله تعالى: (وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ)([666]).
تعني هذه الآية ـ أيضا ـ الغناء والمزامير، وكل متكلّم في غير ذات الله فهو صوت الشيطان([667]).
كما حُرِّم على لسان النبي|، فعن الإمام علي بن أبي طالب÷، عن النبي| قال: «تمسخ طائفة من أمّتي قردة، وطائفة خنازير، ويخسف بطائفة، ويرسل على طائفة الريح العقيم؛ بأنّهم شربوا الخمر ولبسوا الحرير واتّخذوا القيان وضربوا بالدفوف»([668]).
وقال رسول الله|: «إنَّ الله عزَّ وجلَّ بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني بمحق المعازف والمزامير والأوثان...»([669]).
وروي عن يونس قال: سألتُ الخراساني (يعني الإمام الرضا×) عن الغناء وقلت: إنّ العبّاس ذكر عنك أنَّك ترخّص في الغناء، فقال: «كذب الزنديق ما هكذا قلت له، سألني عن الغناء فقلت له: إنّ رجلاً أتى أبا جعفر×، فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان إذا ميّز الله بين الحقِّ والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: حكمت»([670]).
وبسند عن الحسن بن هارون قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: «الغناء يُورث النفاق ويعقب الفقر»([671]).
وبالتالي كيف يُبعث النبي| لكي يمحق الغناء والمزامير، والسيّدة سكينة‘ حفيدة النبي| تجوّز ذلك؟! هذه من المنتحلات نُسبت إليها قصداً، وخاصة بعد أن أصبح الغناء ملازماً للبلاط الأموي، فأرادوا أن يجوّزوا ذلك بحجّة تقبّل بنت رسول الله للغناء، كما أرادوا أن ينقلوا صورة مشوّهة عن السيّدة سكينة‘؛ حتّى ينشغل النّاس بمثل هذه الأخبار، ولا يركّزوا بالعمق التاريخي لثورة الحسين×.
رابعاً: شبهات أخرى
لم يكتفِ أبو الفرج الأصفهاني بالمجالس الشعرية، وتعدّد الأزواج، بل أورد عدّة شبهات لا تمتُّ للسيّدة سكينة‘ بصلة، ولا يُعقل أن تكون من أفعالها.
فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني: أنَّ الأحوص شغف بعقيلة امرأة من ولد عقيل بن أبي طالبE، ثمّ يقول: قد ذكر الزبير عن بنت الماجشون، عن خاله أنّ عقيلة هذه هي سكينة بنت الحسين÷ كُنّى عنها بالعقيلة([672]).
بينما ابن عبد ربّه يقول: «قال الأحوص يوما لمعبد: امضِِ بنا إلى عقيلة؛ حتّى نتحدّث إليها ونسمع من غنائها وغناء جواريها فمضيا، فألفيا على بابها معاذ الأنصاري([673]) وابن صيّاد([674])، فاستأذنوا عليها، فأذِنت لهم إلاّ الأحوص، فإنّها قالت: نحن على الأحوص غضاب، فانصرف الأحوص وهو يلوم أصحابه على استبدادهم بها، وقال:
|
ضنَّتْ عقيلة عنكَ اليوم بالزادِ |
هكذا أمعن الزبيريون في تزوير الحقائق، واتّهام السيّدة سكينة بأمور تتنافى مع القيم الإسلامية.
كما ذكر نموذجاً آخر، وهو أنّ السيّدة سكينة كانت تسمح للرجال بدخول منزلها، فيذكر أبو الفرج الأصفهاني: «أخبرني أحمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدّثنا عمر بن شبه: أنّ الأحوص كان يوماً عند سكينة، فأذَّن المؤذِّن، فلمّا قال أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد أنَّ محمداً رسول الله؛ فخرت سكينة بما سمعت، فقال الأحوص:
|
فخرتْ وانتمتْ فقلتُ ذريني قتيلِ اللحيان يومَ الرجيع |
فأمر سليمان بن عبد الملك أو الوليد بجلده ونفيه([677]).
كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني أن سكينة كانت مزّاحة، أجلست شيخاً فارسيّاً على سلّة بيض، وبعثت سليمان بن يسار كأنّها تريد أن تسأله عن شيء، فجاءها إكراماً لها، فأمرت مَن أخرج إليه ذلك الشيخ جالساً على البيض؛ فولّى يسبّح([678]).
وفي رواية أخرى أنّها بعثت إلى صاحب الشرطة بالمدينة: أنّه دخل علينا شامي فابعث إلينا بالشرطة، فركب ومعه الشرط، فلمّا أتى إلى الباب أمرت ففُتِح له، وأمرت جارية من جواريها فأخرجت إليه برغوثاً، فقال ما هذا؟ قالت: هذا الشامي الذي شكوناه، فانصرفوا يضحكون([679]).
وروى أبو الفرج الأصفهاني: «عن علي بن محمّد النوفلي، عن أبيه وعمّه وغيرهما من مشايخ الهاشميين والطالبيين، أنَّ سكينة بنت الحسين خرجت بها سلعة في أسفل عينها، فكبرت حتّى أخذت وجهها وعينها وعظم شأنها، وكان بدراقس([680]) منقطعاً إليها في خدمتها فقالت له: ألا ترى ما قد وقعتُ فيه؟ فقال لها أتصبرين على ما يمسّك من الألم حتّى أعالجكِ؟ قالت: نعم، فأضجعها وشقَّ جلد وجهها حتّى ظهرت السلعة، ثمّ كشط الجلد عنها واجمع وسلخ اللحم من تحتها حتّى ظهرت عروق السلعة، وكان منها شيء تحت الحدقة، فرفع الحدقة عنه حتّى جعلها ناحية، ثمّ سلَّ عروق السلعة من تحتها فأخرجها أجمع وردَّ العين إلى موضعها، وعالجها وسكينة مضطجعة لا تتحرّك ولا تئن حتّى فرغ مما أراد، فزال عنها وبرئت منها، وبقي أثر تلك الجراحة في مؤخَّر عينها، فكان أحسن شيء في وجهها من كلِّ حلي وزينة، ولم يؤثِّر ذلك في نظرها ولا في عينها»([681]).
إذا أردنا بيان حال الرواة فهم غير معروفين، وعلي بن محمّد النوفلي([682])، ومشايخ هاشميون وطالبيون لم نعرف مَن هم بالضبط؛ وبالتالي فهذه الرواية غير مقبولة، كما تدلُّ على أنَّ أخبار السيّدة سكينة محل اطّلاع الرواة، وأنَّ وجهها كان يراه النّاس، وهذا منافٍ لأخلاق بيت النبي|.
كما يُذكر أنَّها كانت تصفِّف جُمّتها تصفيفاً لم يُرَ أحسن منه، حتّى عُرف ذلك فكانت تلك الجُمَّة تسمّى السكينية، وكان عمر بن عبد العزيز إذا وجد رجلاً قد صفّف جُمَّته السكينية جلده وحلقه([683]).
إنَّ هذا الكلام غير مقبول؛ لأنَّ السيّدة سكينة كانت تراعي الستر والحجاب من صغر سنّها، فهي التي كانت في مجلس يزيد تبكي؛ لأنَّها لم تُستَر بالطريقة المعتادة عليها، فكيف يمكن أن نصدّق أنّها تصفِّف شعرها عندما كبرت، ويكون ذلك محل إشهار بين النّاس؟! وما هذه إلّا محاولة أخرى لتضليل وتزييف الجانب الديني عند السيّدة سكينة‘.
كما يردُّ السيد الصدر على كلِّ تلك الروايات قائلاً: «إنَّ النساء بعد استشهاد الإمام الحسين× قضينَ كلَّ أعمارهنَّ ـ تقريباً بل تحقيقاً ـ بالبكاء والنواح على واقعة الطّف وشهدائها، فالسيّدة سكينة‘ إن كانت مع الباكيات كما هو الأمر الواقع فلا معنى لأن تكون باكية ومزّاحة في عين الوقت...، كما أنَّ الائمة كانوا معها طول حياتها، الحسن والحسين وزين العابدين والباقر^، ولا شكَّ أنَّ الأئمة كلّهم كان لهم اهتمام خاصّ بصيانة أُسرهم وكثافة الستر في نسائهم، فلا يُحتمل أن يكون شيء ما يفلت بهذه السعة والوضوح وهم لا يستطيعون تغييره»([684]).
وأخيراً نختم بمقولة بهاء الدين العاملي التي يقول فيها: «عبد الله بن مصعب كان من أشرِّ النّاس، ومتحاملاً على ولد علي...، ومصعب الزبيري هو ابن هؤلاء، وما في الآباء ترثه الأبناء، على أنَّ احتمال التدليس فيه أقوى؛ لأنّ في الزبيريين ثمّة سكينة بنت خالد بن مصعب كانت ترتاد محفل الغناء، فمحوا العار عن الزبيريين ببهت العلويين بما ليس فيهم»([685]).
لقد استعرضت تاريخ السيّدة سكينة بنت الحسين÷، الذي توخّيت فيه الدقّة العلمية والرصانة للوصول إلى الحقيقة التاريخية المجرّدة، وسأحاول في هذه الخاتمة تسليط الضوء على بعض الحقائق التي توصّلت إليها، فضلا عمّا سيجده القارئ في أثناء البحث من آراء واستنتاجات وتحليلات علمية:
1ـ لم يحدِّد الرواة سنة ولادة السيّدة سكينة‘، ولكنّي وجدت عام 47هـ هو الأقرب، مع عدم وجود خبر قطعي يُركَن إليه في تحديد عمرها، إلاّ أنَّها كانت في واقعة الطّف فتاة واعية واجهت الكثير من المواقف التي تؤكِّد وعيها وفهمها، فتكون ما بين (11ـ14) عاماً في واقعة الطف.
2ـ اختلف الرواة في اسمها ما بين (آمنة ـ أُميمة ـ أمينة) ولكنهم اتفقوا على أنّ سكينة هو لقب لُقِّبت به؛ وذلك لما تميّزت به من هدوء ووقار منذ صغرها.
وإثبات الاسم ضروري، وذلك لتشابه الأسماء في كتب التاريخ والأدب.
وقد رجحت اسم (آمنة)؛ وذلك تبعاً لبقية الأسماء التي وردت في المصادر، فكلّ تلك الأسماء عبارة عن تصحيف لاسم (آمنة).
3ـ لم تذكر لنا المصادر التاريخية القديمة أيّة أخبار عن نشأتها الأولى، ممّا ضيّع علينا مرحلة مهمّة من تاريخ هذه السيّدة الجليلة، ولكن ذلك لم يُثنِنا عن محاولات البحث والتقصّي عن تلك الفترة؛ إذ حاولنا قراءة ما بين السطور للوصول إلى بعض الأخبار التي تسلّط الضوء على هذه المرحلة من حياتها، فقد كان للتربية الصحيحة أثر واضح على سلوكها، ممّا جعلها تمارس حياتها كامرأة مسلمة ملتزمة بالآداب القرآنية والسنّة النبوية الشريفة، فانعكس هذا إيجابياً على سلوكها، فأصبحت المرأة المثالية في عصرها.
4ـ لم تكن السيّدة معزولة عن أحداث المجتمع الإسلامي، فقد عاشت عصراً تغيّرت فيه مفاهيم الدين الإسلامي الحقيقية؛ حيث أخذ الأمويون بسبِّ الإمام علي× على المنابر، وقتل أولاد النبي|، واضطهاد محبي أهل البيت^. وأمّا من الناحية الإجتماعية فقد تميّز عصر بني أميّة بالفسوق وكثرة المحرّمات، وبدأ الغناء والموسيقى واللهو يظهر بشكل واسع، وبدأ الخلفاء يعقدون لها مجالس خاصّة، وينفقون بسخاء على المغنّين والشعراء، بل انتعش الغناء والموسيقى والشعر في عهد معاوية وعبد لملك والوليد وسليمان وهشام من الخلفاء الأمويين.
5ـ لقد اكتسبت السيّدة سكينة خبرة ووعياً ثقافياً وسياسياً نتيجة مشاركتها مع باقي النساء العلويات في المسير إلى كربلاء، والأحداث السياسية التي مرّت بها، ممّا جعلها قادرة على تمييز الأمور من خلال معطياتها سواء السياسية منها أوالإجتماعية، فقد تحمّلت مسؤولية كبيرة في مواجهة الإعلام الأموي، فكانت لسان صدق ينطق بالحقّ؛ فكان لكلامها أثر في نفوس النّاس.
6ـ لقد كانت السيّدة سكينة شاهدة على كلّ أحداث واقعة الطف، فأخذت تروي الأحداث عبر التاريخ، كما قامت بدور مكمِّل لأدوار النساء العلويات، وهي في قمّة الوعي والذكاء، وكانت تنتظر دورها، حتّى إذا ما حان الوقت وقفت وقفة امرأة شجاعة تشكر الله على البلاء وتفتخر بشهادة والدها وإخوتها، ساخطة على يزيد وأتباعه.
7ـ إنَّ الرؤيا التي رأتها السيّدة سكينة في منامها أصعقت يزيد وأنَّبتْه، فكانت إحدى الأسباب التي جعلت يزيد يفكر في عودة السبايا إلى المدينة.
8ـ إنّ الدور الفعلي للسيّدة سكينة بدأ حين وفاة السيّدة زينب‘، فقامت بإحياء مجالس العزاء، وبثّ شرارة الثورة الحسينية ومبادئها، فعملت كمبلغة بكلِّ ما يتعلّق بثورة الإمام الحسين×، فقد مارست الدور الإعلامي المضادّ واستمرت على ذلك حتّى وفاتها.
9ـ لم تنسَ السيّدة سكينة شهادة أبيها، ولا الأحداث التي مرّت عليها في سنة 61هـ، فقد عاشت حالة مأساوية كما عاشت وقتاً عصيباً تكلّل بالمصائب؛ فبعد استشهاد الإمام الحسين× تُوفيت السيّدة أمُّ كلثوم، ثمّ السيّدة زينب‘ ثمّ الرباب ثمّ محمّد بن الحنفية، ثمّ الإمام السجاد×، فقد رافقتها الأحزان.
10ـ لقدكشفت أحاديث السيّدة سكينة الكثير من الحقائق التاريخية المخبأة حول وحشيّة الجيش الأموي وضعفه وتفكّكه، وحول عدد أصحاب الإمام الحسين×، وحال الحسين× عند استشهاد ذويه وغيرها.
11ـ لقد تزوّجت السيّدة سكينة من عبد الله الأكبر ابن الإمام الحسن المجتبى× وهو أخو الإمام القاسم، ولم تتزوّج من القاسم كما يدور على ألسنة النّاس.
كما أنّ لقبها بفتح السين وليس بضمِّها، كما يلفظها عامّة النّاس.
12ـ مناقب وفضائل السيّدة سكينة كثيرة، حيث لقِّبت سيّدة نساء عصرها، فهي أهل الفضل والجود، وكانت عابدة مستغرقة في عبادتها ولم تنسَ صلاتها وعبادتها حتّى في مجلس يزيد، وكانت ترى المصائب نعماً من أنعم الله عليهم أهل البيت.
13ـ عند رجوع السيّدة سكينة إلى المدينة أنشأت مجالس دينية، وعملت على تكريس باقي حياتها للعبادة، كما أنّها لم تخرج من المدينة، ولو خرجت فبسبب سياسي (ضغط أموي) ولكنها رجعت إلى المدينة، والدليل على ذلك ما ذكرته المصادر من أنَّ مكان دفنها في المدينة.
14ـ لقد كانت نهاية الحياة المباركة للسيّدة سكينة‘ سنة 117هـ، في ربيع الأول، وكان ذلك اليوم يوم الخميس، وعمرها الشريف يوم وفاتها مختلَف فيه، فقد قيل: كان عمرها ثمانين سنة أو أقلّ.
15ـ إنَّ البقعة التي شهدت آخر أنفاسها مختلَف فيها بين المؤرِّخين، وأمّا ما تحتضنه الحواضر من مشاهد تُنسب إليها فمتعدّدة كذلك، والأماكن المنسوبة إليها عدّة ما بين (المدينة ـ مكّة ـ طبرية ـ مصر ـ الشام)، إلاّ أنَّ المعروف أنّها تُوفيت في المدينة، ويصحّحه كثير من المؤرّخين.
16ـ تعرّضت سيرة السيّدة سكينة للوضع والدّسِّ للنيل من كرامة أهل البيت^، حيث قام الوضّاعون والحاقدون بافتعال واصطناع جملة من الأخبار التي لاأساس لها من الصحة ولا ترتبط بالسيدة سكينة؛ لذا فهي لا تصمد أمام المناقشة والنقد والتحليل، وبذلك تفقد مقوّماتها وتصبح مشوّهة تنمُّ عن سذاجة وافتراء وكذب واضعها، مهما بلغت به حرفة الدسّ والوضع والتلفيق، واتّضح لي أيضاً أنَّه خاضع لعامل السياسة والكره والبغضاء، والعيش على فتات موائد الحاكم المنحرف الظالم.
* القرآن الکریم.
أولاً: المصادر الأولية
2. ابن الأبار، محمّد بن عبد الله بن أبي بكر(ت658هـ/1259م):
3. الحلة السيراء، تح: حسين مؤنس، دار المعارف، ط2، القاهرة، 1985م.
4. دُرر السمط في خبر السبط، تح: عزّ الدين عمر موسى، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1407هـ.
5. الابشيهي، شهاب الدين محمّد بن أحمد بن منصور(ت852هـ/ 1448م):
6. المستطرف في كل فنّ مستطرف، عالم الكتب، بيروت، 1419هـ.
7. ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم(ت630هـ/1232م):
8. أُسد الغابة في معرفة الصحابة، تح: معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، د.م، 1994م.
9. الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 1997م.
10. اللباب في تهذيب الأنساب، دار صادر، بيروت، د.ت.
11. ابن الأثير، أبو السعادات المبارك محي الدين(ت606هـ/1209م):
12. النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت، 1979م.
13. ابن الأثير الكاتب، نصر الله بن محمّد بن عبد الكريم، (637هـ/1139م):
14. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة، القاهرة، د.ت.
15. الآجري، أبو بكر محمّد بن الحسن(ت360هـ/970م):
16. الشريعة، تح: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، ط2، الرياض، 1999م.
17. الإدريسي، محمّد بن محمّد بن عبد الله(ت560هـ/1164م):
18. نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بيروت، 1409هـ.
19. الأربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح(ت693هـ/1293م):
20. كشف الغمّة في معرفة الأئمة، دار الأضواء، ط2، بيروت، 1985م .
21. الأزهري، محمّد بن أحمد(ت370هـ/ 980م):
22. الزاهد في غريب الفاظ الشافعي، تح: مسعد عبد الحميد السعدوني، دار الطلائع، د.م، د.ت.
23. الاسفرايني، أبو إسحاق(ت ق 10 هـ/16م):
24. نور العين في مشهد الحسين×، المنار، تونس، د.ت.
25. الأصفهاني، أبو محمّد عبد الله بن محمّد(ت369هـ/979م):
26. طبقات المحدثين باصبهان والواردين عليها، تح: عبد الغفور عبد الحق، مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت، 1992م.
27. ابن أعثم الكوفي، أبي محمّد أحمد(ت314هـ/926م):
28. الفتوح، تح: علي شبري، دار الاضواء للطباعة، بيروت، 1411هـ.
29. ابن الإعرابي، أحمد بن محمّد بن زياد بن بشر(ت340هـ/916م):
30. معجم ابن الإعرابي، تح: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد، دار ابن الجوزي، السعودية، 1997م.
31. الأنباري، محمّد بن قاسم بن محمّد(ت328هـ/939م).
32. الزاهر في معاني كلمات الناس، تح: حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1992م.
33. (ب)
34. الباعوني، شمس الدين أبي البركات محمّد بن أحمد(ت871هـ/ 1466م):
35. جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب×، تح: محمّد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم، 1416هـ.
36. البحراني، عبد الله بن نور الله(ت1130هـ / 1717م):
37. عوالم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال، تح: مدرسة الإمام المهدي، قم، 1407هـ.
38. البحراني، هاشم الحسيني(ت1107هـ /1695م):
39. البرهان في تفسير القران، تقديم:محمد مهدي الآصفي، قسم الدراسات الإسلامية، قم، (د.ت).
40. بحرق اليمني، محمّد بن عمر بن مبارك(ت 930هـ / 1524م):
41. حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، تح: محمّد غسّان، دار المنهاج، جدة، 1429هـ.
42. البخاري، محمّد بن اسماعيل بن إبراهيم(ت256هـ/869م):
43. تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، إعداد محمّد عبد الكريم، مكتبة الرشيد، الرياض، 1999م.
44. بدر الدين العيني، أبو محمّد محمود بن أحمد(ت855هـ/1451م):
45. مغاني الأخبار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، تح: محمّد حسن محمّد حسن اسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، 2006م.
46. البرقي، أبو جعفر أحمد بن محمّد(ت274هـ/887م):
47. المحاسن، تح: جلال الدين الحسيني، دار الكتب الإسلامية، د.ت، د.م.
48. البري، محمّد بن أبي بكر بن عبد الله(ت بعد 645 هـ/1247م):
49. الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، تح: محمّد التونجي، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، بيروت، 1402هـ.
50. الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، علّق عليه: محمّد الشوينجي، دار الرفاعي، الرياض، 1983م.
51. ابن بسّام، أبو الحسن علي الشنتوني(ت542هـ/1147م):
52. الذخيرة في محاسن أهل الجيرة، تح: احسان عباس، دارالعربية للكتاب، تونس، 1979م.
53. ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك(ت449هـ/ 1057م):
54. شرح صحيح البخاري، تح: أبو حاتم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشيد، ط2، الرياض، 2003م.
55. ابن بطوطة، محمّد بن عبد الله بن محمّد(ت779هـ /1377م):
56. تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 1417هـ.
57. البعلي، محمّد بن أبي الفتح(ت 709هـ/1309م):
58. المطّلع على الفاظ المقنع، تح: محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب، مكتبة السوادي، د.م، 2003م.
59. البغدادي، عبد القادر بن عمر(ت1093هـ/1682م):
60. تالي تلخيص المتشابه، تح: مشهور بن حسن آل سلمان وأحمد الشقيرات، دار الاصمعي، الرياض، 1417هـ.
61. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخارجي، ط4، القاهرة، 1997م.
62. البغوي، أبو محمّد الحسين بن مسعود(ت510هـ/1116م):
63. معالم التنزيل في تفسير القرآن، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1420هـ.
64. أبو البقاء، أيوب بن موسى(ت1094هـ / 1682م):
65. الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت.
66. البقاعي، إبراهيم بن عمر بن الحسن الرباط(ت885هـ/1480م):
67. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تح: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1995م.
68. البكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمّد(ت487هـ/ 1094م):
69. التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه، دار الكتب والوثائق القومية، ط2، القاهرة، 2000م.
70. معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، عالم الكتب، ط3، بيروت، 1403هـ.
71. البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابربن داود(ت279هـ/892م):
72. أنساب الأشراف، تح: محمّد باقر المحمودي، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1974م.
73. بهاء الدين العاملي، محمّد بن حسين بن عبد الصمد، (953هـ/ 1622م):
74. الكشكول، تح: محمّد مهدي سيد حسن الخرساني، المطبعة الحيدرية، النجف، 1973م.
75. البهبهاني، محمّد باقر الوحيد(ت1205هـ/1790م):
76. الرسائل الفقهية، منشورات مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني، د.م، 1419هـ.
77. البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر(ت685هـ/ 1286م):
78. أنوار التنزيل واسرار التأويل، تح: محمّد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1418هـ.
79. البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى(ت458هـ/1066م):
80. الآداب، تح: أبو عبد الله السعيد المندوة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1988م.
81. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تح: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1401هـ.
82. السنن الكبرى، تح: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط3، بيروت، 2003م.
83. البيهقي، أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد(ت 565هـ/1169م):
84. تاريخ بيهق، دار اقرأ، دمشق، 1425هـ.
85. لباب الأنساب والألقاب والاعقاب، د.م، د.ت.
86. معارج نهج البلاغة، تح: محمّد تقي دانش، إشراف: محمود المرعشي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي، قم، 1409هـ.
87. (ت)
88. الترمذي، محمّد بن عيسى بن سورة(ت279هـ/892م):
89. الجامع الكبير ـ سنن الترمذي، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م.
90. ابن تغري بردي، أبو المحاسن يوسف بن عبد الله(ت874هـ/ 1469م):
91. مورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافة، تح: نبيل محمّد عبد العزيز أحمد، دار الكتب المصرية، القاهرة، د.ت.
92. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب، مصر، د.ت.
93. التفرشي، مصطفى بن الحسين الحسيني(ت ق 11هـ/16م):
94. نقد الرجال، مؤسسة أل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1418م.
95. التوبلي، هاشم البحراني الموسوي(ت1107هـ/1695م):
96. غاية المرام وحجّة الخصام في تعيين الإمام عن طريق الخاص والعام، تح: السيد علي عاشور، د.م، د.ت.
97. ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس(ت728هـ/1326م):
98. قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة، تح: ربيع بن هادي عمير المدخلي، مكتبة الفرقان، عجمان، 2001م..
99. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تح: رشاد سالم، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، د.م، 1986م.
100. (ث)
101. الثعالبي، عبد الملك بن محمّد بن اسماعيل(ت429هـ/1038م):
102. ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، دار المعارف، القاهرة، د.ت.
103. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تح: مفيد محمّد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م.
104. الثعلبي، أحمد بن محمّد بن إبراهيم(ت 427 هـ/1035م):
105. الكشف والبيان عن تفسير القران الكريم، تح: أبو محمّد بن عاشور، تدقيق: نضير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2000م. (ج)
106. الجاحظ، عمر بن بحر بن محبوب(ت 255هـ / 869 م):
107. البيان والتبيين، الناشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، 1423هـ.
108. الحيوان، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1424هـ.
109. الرسائل الأدبية، دار ومكتبة الهلال، ط2، بيروت، 1423هـ.
110. ابن جبر، زين الدين علي بن يوسف(ت ق 7 هـ/13م):
111. نهج الايمان، تح: السيد أحمد الحسيني، مجتمع امام هادي×، مشهد، 1418هـ.
112. الجراوي، أحمد بن عبد السلام(ت609هـ/1212م):
113. الحماسة البصرية، تح: محمّد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1991م.
114. الجرجاني، علي بن محمّد بن علي(ت816هـ/1413م):
115. التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، 1983م.
116. الجزائري، نعمة الله(ت1112هـ/1700م):
117. الأنوار النعمانية، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1984م.
118. ابن الجزري، محمّد بن محمّد بن علي بن يوسف(ت833هـ/1429م):
119. غاية النهاية في طبقات القرّاء، مكتبة ابن تيمية، د.م، د.ت.
120. مناقب الأسد الغالب ممزّق الكتائب ومظهر العجائب ليث بن غالب أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تح: طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن، د.م، 1994م.
121. ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد الهاشمي(ت230هـ/845م):
122. مسند ابن الجعد، تح:عامر أحمد حيدر، مؤسسة نادر، بيروت، 1990م.
123. الجمحي، محمّد بن سلام(ت232هـ/846م):
124. طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محمّد شاكر، القاهرة، 1974م.
125. ابن الجوزي، ابن الفرج عبد الرحمن بن علي(ت597هـ/1200م):
126. صفة الصفوة، تح: أحمد بن علي، دار الحديث، القاهرة، 2000م.
127. الضعفاء والمتروكون، تح: عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1406هـ.
128. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تح: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 19920م.
129. الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حمّاد(ت393هـ/1002م):
130. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، ط4، بيروت، 1987م.
131. (ح)
132. الحافظ المزي، جمال الدين بن الزكي(ت742هـ/1341م):
133. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1980م.
134. الحاكم النيسابوري، أبوعبد الله الحاكم بن محمّد بن عبد بن محمّد (ت405هـ/1014م):
135. فضائل فاطمة الزهراء، تح: علي رضا بن عبد الله بن علي، دار الفرقان، القاهرة، 1429هـ.
136. المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.
137. ابن حبان، محمّد بن حبان بن أحمد(ت354هـ 965م):
138. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان، ترتيب، الأمير علاء الدين، تعليق: شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1988م.
139. الثقات، دائرة المعارف العثمانية، الهند، 1973م.
140. السيرة النبوية وأخبار الخلفاء، صحّحه وعلّق عليه: السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، الكتب الثقافية، ط3، بيروت، 1417هـ.
141. مشاهير علماء الأمصار وإعلام فقهاء الأقطار، تح: مرزوق علي إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، 1991م.
142. ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد (ت852هـ/ 1448م):
143. الإصابة في تمييز الصحابة، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1415هـ.
144. تقريب التهذيب، تح: محمّد عوامة، دار الرشيد، سوريا، 1986م.
145. تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة النظامية، الهند، 1326هـ.
146. فتح الباري شرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن عبد الله، دار المعرفة، ط2، بيروت، 1379هـ.
147. لسان الميزان، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، د.م، 2002م.
148. نزهة الألباب في الألقاب، تح: عبد العزيز محمّد صالح السريري، مكتبة الرشد، الرياض، 1989م.
149. ابن حجر الهيثمي، أبو العباس أحمد بن محمّد(ت974هـ/1566م):
150. الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، تح: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكمال محمّد الخراط، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1997م.
151. ابن أبي الحديد، عبد الحميد هبة الله(ت656هـ/1258م):
152. شرح نهج البلاغة، دار إحياء الكتب العربية، ط2، قم، 1967م.
153. الحرضي، يحيى ابن أبي بكر بن محمّد(ت893هـ/1487م):
154. بهجة المحافل وبغية الاماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، دار صادر، بيروت، د.ت.
155. الحر العاملي، محمّد بن الحسين(ت1104هـ/1692م):
156. أمل الآمل، تح: أحمد الحسيني، دارالكتب الإسلامي، قم، د.ت.
157. هداية الأمّة إلى أحكام الأئمة^، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، 1413هـ.
158. الحريري، القاسم بن علي بن محمّد(ت516هـ/1122م):
159. درة الغواص في أوهام الخواص، تح: مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1998م.
160. ابن حزم الاندلسي، أبو محمّد علي بن أحمد(ت456هـ/1063م):
161. رسائل ابن حزم الاندلسي، تح: احسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط2، ، بيروت، 1987م.
162. الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة الخارجي، القاهرة، د.ت.
163. المحلّى، تح: أحمد محمّد شاكر، دار الفكر، بيروت، د.ت.
164. الحسكاني، عبيد الله بن أحمد(ت ق 5 هـ/11م):
165. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في آيات النازلة في أهل البيت^، تح: شيخ محمّد باقر محمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، د.م، 1411هـ.
166. الحسيني، تاج الدين بن محمّد، (كان حيّاً سنة 753هـ/1352م):
167. غاية الاختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار، تح: محمّد صادق بحر العلوم، د.م، 1962م.
168. الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي(ت726هـ/1325م):
169. تذكرة الفقهاء، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1417هـ.
170. خلاصة الأقوال، المطبعة الحيدرية، ط2، النجف، 1281هـ.
171. ابن حمدون، محمّد بن الحسن بن محمّد (ت562هـ/1166م):
172. التذكرة الحمدونية، دار صادر، بيروت، 1417هـ.
173. ابن حمزة الحسيني، إبراهيم بن محمّد بن محمّد(ت1120هـ/1611م):
174. البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، تح: سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
175. حموش، أبو محمّد مكي بن أبي طالب(ت437هـ/1045م):
176. الهواية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، إشراف: الشاهد البوشيخي، الشارقة، 2008م.
177. الحموي، أبو بكر بن علي بن عبد الله، (837هـ/1433م):
178. طيب المذاق من ثمرات الأوراق، تح: أبو عمار السخاوي، دار الفتح، الشارقة، 1997م.
179. الحميري، أبو العباس عبد الله بن جعفر(ت304هـ/916م):
180. قرب الإسناد، تح: مؤسسة إحياء التراث، قم، 1413هـ.
181. الحميري، أبو عبد الله بن محمّد(ت900هـ/1494م):
182. الروض المعطار في خير الأقطار، تح: احسان عباس، مؤسسة ناصر، ط2، بيروت، 1980م.
183. -
184. ابن حنبل، عبد الله أحمد بن محمّد(ت241هـ/855م):
185. فضائل الصحابة، تح: وصي الله محمّد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1983م.
186. مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، د.م، 2001م.
187. (خ)
188. الخركوشي، عبد الملك بن محمّد بن إبراهيم(ت407هـ/1016م):
189. شرف المصطفى، دار البشائر الإسلامية، مكّة، 1424هـ.
190. الخزار القمي، أبو القاسم علي بن محمّد(ت400هـ/1009م):
191. كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، تح: عبد اللطيف الحسيني، انتشارات بيدار، قم، 1401هـ.
192. الخزرجي، أحمد بن عبد الله بن أبي الخير(ت923هـ/1517م):
193. خلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، دار البشائر، ط5، حلب ـ بيروت، 1416هـ.
194. ابن خزيمة، أبو بكر محمّد بن اسحاق(ت311هـ):
195. كتاب التوحيد وإثبات صفات الربّ عزّ وجلّ، تح: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، ط5، الرياض، 1994م.
196. الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمّد(ت388هـ/997م):
197. غريب الحديث، تح: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد ربّ النبي، دار الفكر، د.ت، 1982م.
198. الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي (ت463هـ/1072م):
199. تاريخ مدينة السلام وأخبار محدّثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2002م.
200. المتفق والمفترق، تح: محمّد صادق آيدن الحامدي، دار القادري، دمشق، 1417هـ.
201. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمّد بن محمّد(ت808هـ/1405م):
202. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومَن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تح: خليل شحادة، دار الفكر، ط2، بيروت، 1988م.
203. ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد، (681هـ/1282م).
204. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح: احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، د.ت.
205. خليفة بن خياط، أبو عمر خليفة الشيباني العصفري(ت240هـ/ 854م):
206. تاريخ خليفة بن خياط، تح: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، ط2، بيروت، 1397هـ.
207. طبقات خليفة بن خياط، تح: سهيل زكار، دار الفكر، د.م، 1993م.
208. الخوارزمي، الموفق بن أحمد بن محمّد المكي(ت568هـ/1172م):
209. المناقب، تح: مالك المحمودي، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، قم، 1411هـ.
210. (د)
211. الدار قطني، أبو الحسن علي بن أحمد(ت385هـ/995م):
212. المؤتلف والمختلف، تح: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1986م.
213. الدارمي، أبو عبد الله بن عبد الرحمن(ت255هـ/868م):
214. سنن الدارمي، تح: حسين سليم اسد الداراني، دار المغني، المملكة العربية السعودية، 2000م.
215. ابن دريد، أبو بكر محمّد بن الحسن(ت321هـ/933م):
216. جمهرة اللغة، تح: مزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، 1987م.
217. الدولابي، أبو بشر محمّد بن أحمد(ت310هـ/922م):
218. الذرية الطاهرة النبوية، تح: سعد المبارك الحسن، الدار السلفية، الكويت، 14هـ.
219. ابن أبي الدنيا، أبو بكر عبد الله بن محمّد(ت281هـ/833م):
220. الإشراف في منازل الأشراف، تح: نجم عبد الرحمن خلف، مكتبة الرشد، الرياض، 1990م.
221. المتمنيين، تح: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، 1997م.
222. الديار بكري، حسين بن محمّد بن الحسن(ت966هـ/1558م):
223. تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، بيروت، د.ت.
224. الديلمي، شيروبه بن شهر دار بن شيرو بن فنا خسرو (ت509هـ/ 1115م).
225. الفردوس المأثور الخطاب، تح: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م.
226. الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود(ت282هـ/895م):
227. الأخبار الطوال، تح: عبد المنعم عامر، مراجعة: جمال الدين الشيال، دار إحياء الكتب العرب، القاهرة، 1960م. (ذ)
228. أبو ذر، أحمد بن إبراهيم بن محمّد(ت884هـ/1479م):
229. كنوز الذهب في تاريخ حلب، دار القلم، حلب، 1417هـ.
230. -
231. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله بن احمد(ت748هـ/1347م):
232. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح: عمر عبد السلام التدميري، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
233. سير أعلام النبلاء، تح: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الارناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، د.م، 1985م.
234. العبر في خبر من غبر، تح: أبو هاجر محمّد السعيد، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
235. الكاشف في معرفة مَن له دراية في الكتب الستّة، تح: محمّد عوامة، دار القبلة الثقافية الإسلامية، جدة، 1992م.
236. المغني في الضعفاء، تح: نور الدين عتر، د.م، د.ت.
237. المقتنى في سرد الكنى، تح: محمّد صالح عبد العزيز، مجلس العلمي، المدينة المنورة، 1408هـ.
238. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تح: علي محمّد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، 1963م.
239. (ر)
240. الرازي، زين الدين أبو عبد الله(ت بعد 666هـ/1267م):
241. مختار الصحاح، تح: يوسف الشيخ محمّد، المكتبة العصرية والدار النموذجية، ط5، بيروت وصيدا، 1999م.
242. الراغب الاصفهاني، أبو القاسم بن محمّد(ت502هـ/1108م):
243. المفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم ودار الشافيه، دمشق وبيروت، 1412هـ.
244. ابن راهوية، أبو يعقوب اسحاق ابن إبراهيم(ت238هـ/852م):
245. مسند اسحاق بن راهوية، تح: عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، 1991م.
246. الراوندي، خطيب الدين سعيد بن هبة الله، (573هـ/1177م):
247. الخرائج والجراح، تح: مؤسسه الإمام المهدي، د.ت، د.م.
248. ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن(ت795هـ/1392م):
249. روائع التفسير، جمع وترتيب: أبو معاذ صادق بن عوض، دار العاصمة، السعودية، 2001م.
250. ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني(ت463هـ/1071م):
251. العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط5، د.م، 1981م.
252. الروياني، أبو بكر محمّد بن هارون(ت307هـ/919م):
253. مسند الروياني، تح: أيمن علي يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، 1416هـ.
254. (ز)
255. الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق(ت 1205هـ/1790م):
256. تاج العروس من جواهر القاموس، تح: علي شبري، دار الفكر، بيروت، 1994م.
257. الزبير بن بكار، عبد الله القريشي الاسدي(ت 256هـ/869م):
258. الأخبار الموفقيات، تح: سامي مكي العاني، عالم الكتب، ط2، بيروت، 1996م.
259. جمهرة نسب قريش وأخبارها، تح: محمود محمّد شاكر، مطبعة المدني، د.م، 1381هـ.
260. الزبيري، مصعب بن عبد الله(ت236هـ/850م):
261. نسب قريش، تح: ليفي بروفنسال، دار المعارف، ط3، القاهرة، د.ت.
262. الزجاجي، عبد الرحمن بن اسحاق(ت337هـ/948م):
263. الأمالي، تح: عبد السلام هارون، دار الجيل، ط2، بيروت، 1987م.
264. الزمخشري، جار الله أبو القاسم محمود بن عمر(ت 538هـ/1143م):
265. الجبال والأمكنة والمياه، تح: أحمد عبد التواب عوض المدارس، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999م.
266. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1412هـ.
267. الفائق في غريب الحديث والأثر، تح:علي محمّد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، ط2، لبنان، د.ت.
268. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل في وجوه التأويل، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
269. ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة(ت251هـ/865م):
270. الأموال، تح: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل، السعودية، 1986م.
271. الزوزني، حسين بن أحمد بن حسين(ت486هـ/1093م):
272. شرح المعلقات السبع، دار إحياء التراث العربي، د.م، 2002م.
273. (س)
274. سبط ابن الجوزي، أبو المظفر بن يوسف شمس الدين(ت654هـ /1256م):
275. تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة، ت: عامر النجار، مكتبة الثقافة الدينية، د.م، 2008م.
276. السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين(ت771هـ/ 1369م):
277. طبقات الشافعية الكبرى، تح: محمود محمّد وعبد الفتاح محمّد، دار هجر، ط2، د.م، 1413هـ.
278. سبهر، لسان الملك ميرزا محمّد تقي، (1216هـ/1801م):
279. ناسخ التواريخ حياة الإمام سيد الشهداء الحسين×، ترجمة: سيد علي جمال أشرف، انتشارات مدين، قم، 2007م.
280. السخاوي، علي بن محمّد بن عبد الصمد(ت643هـ/1245م):
281. جمال القراء وكمال الإقراء، تح: مروان العطية محسن خرابة، دار المأمون، بيروت، 1997م.
282. السخاوي، محمّد بن عبد الرحمن(ت902هـ/1496م):
283. التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993م.
284. السراج القاري، جعفر بن أحمد الحسين(ت500هـ /1106م):
285. مصارع العشّاق، دار صادر، بيروت، د.ت.
286. ابن سعد، أبو عبد الله محمّد بن منيع(ت230هـ/844م):
287. الطبقات الكبرى، تح: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.
288. الطبقات الكبير، تح: علي محمّد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2001م.
289. السكّاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن علي، (626هـ/1229م):
290. مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1987م.
291. ابن سنان الخفاجي، أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن سعيد، (466هـ/ 1073م):
292. الفصاحة، دار الكتب العلمية، د.م، 1982م.
293. السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله(ت581هـ/1185م):
294. الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، دار إحياء التراث، بيروت، 1412هـ.
295. ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت458هـ/1065م):
296. المخصص، تح: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1996م.
297. السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(ت911هـ/1505م):
298. تاريخ الخلفاء، تح: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار مصطفى الباز، د.م، 2004م.
299. جامع الاحاديث، إشراف: علي جمعة، د.م، د.ت.
300. الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت، د.م.
301. الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، دار المعرفة، جدّة، 1365هـ.
302. (ش)
303. الشامي، محمّد بن يوسف الصالحي(ت942هـ/1534م):
304. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، تح: عادل أحمد وعلي محمّد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1993م.
305. الشريف الرضي، محمّد بن الحسين بن موسى(ت403هـ/1012م):
306. نهج البلاغة (مجموعة خطب الإمام علي×)، تح: محمّد عبده، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
307. ابن شعبة الحراني، أبو محمّد الحسن بن علي(ت ق 4هـ):
308. تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليهم، تح: علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، قم،1363ش.
309. الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد بن علي(ت673هـ/1274م):
310. لوافح الأنوار في طبقات الأخيار، مكتبة محمّد المليجي، مصر، 1315هـ.
311. ابن شهر آشوب، شير الدين أبي عبد الله(ت588هـ/1192م):
312. مناقب آل أبي طالب، تح: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، النجف، 1956م.
313. الشهرستاني، محمّد بن عبد الكريم بن أحمد(ت548هـ/1153م):
314. الملل والنحل، تح: محمّد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، 1404هـ.
315. الشوكاني، محمّد بن علي بن محمّد(ت1250هـ/1834م):
316. نيل الأوطار شرح منقى الأخبار، تح: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، د.ت.
317. ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمّد(ت235هـ/849م):
318. مسند أبي شيبة، تح: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن مزيد المزيدي، دار الوطن، الرياض، 1997م.
319. المصنف في الأحاديث والآثار، تح: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، ط2، الرياض، 1409هـ.
320. الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي(ت476هـ/1083م):
321. طبقات الفقهاء، هذبهُ: محمّد بن مكرم بن منظور(ت711هـ/1311م)، تح: دار الرائد العربي، بيروت، 1970م.
322. (ص)
323. ابن صبان، محمّد بن علي المصري(ت 1206هـ/1791م):
324. إسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين المطبوع بهامش نور الابصار للشبلنجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
325. صدر الدين البصري، علي بن أبي الفرج بن الحسن(ت659هـ/ 1260م):
326. الحماسة البصرية، تح: مختار الدين أحمد، عالم الكتب، بيروت، د.ت.
327. الصدوق، أبو جعفر محمّد بن علي(ت318هـ/930م):
328. الأمالي، تح: قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسة البعثة، قم، 1417هـ.
329. الخصال، تعليق: علي أكبر الغفاري، جمع المدرسين، قم، د.ت.
330. الصفدي، صلاح الدين خليل بن ابيك(ت 764هـ /1363م):
331. الشعور بالعور، تح:عبد الرزاق حسين، دار عمان، الأردن، 1988م.
332. الوافي بالوفيات، تح: أحمد الارناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2000 م.
333. الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام(ت211هـ/826م):
334. المصنف، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط2، بيروت، 1403هـ.
335. (ط)
336. أبو طاهر المخلص، محمّد بن عبد الرحمن(ت393هـ/1002م):
337. المخلصيات، تح: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 2008م.
338. ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر(ت664هـ/1265م):
339. اللهوف في قتلى الطفوف، أنوار الهدى، قم، 1417هـ.
340. الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب(ت360هـ/970م):
341. المعجم الكبير، تح: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، ط2، الموصل، 1983م.
342. مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، تح: محمّد شجاع ضيف الله، دار الأوراد، الكويت، 1992م.
343. الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن(ت548هـ/1153م):
344. تاج المواليد في مواليد الأئمة ووفياتهم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي، نجف، د.ت.
345. مكارم الأخلاق، منشورات الشريف الرضي، ط6، د.م، 1972م.
346. الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم(ت ق5هـ/11م):
347. دلائل الإمامة، قسم الدراسات الإسلامية، قم، 1413هـ.
348. الطبري، محمّد بن جرير بن زيد(ت310هـ/923م):
349. استشهاد الحسين ويليه راس الحسين لابن تيمية، تح: السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط2، بيروت، 1988م.
350. تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ.
351. المنتخب في كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعيين، دار التراث، ط2، بيروت، 1387هـ.
352. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمّد(ت321هـ/933م):
353. شرح مشكل الآثار، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، د.م، د.ت.
354. ابن طرار، أبو الفرج المعافي بن زكريا(ت390هـ/999م):
355. الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، تح: عبدالكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2005م.
356. الطريحي، فخر الدين بن محمّد(ت1085هـ/1674م):
357. المنتخب للطريحي، موسوعة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، د.ت.
358. ابن الطقطقي، محمّد بن علي بن طباطبا(ت709هـ/1309م):
359. الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، تح: عبد القادر محمّد ماير، دار القلم العربي، بيروت، 1997م.
360. ابن طلحة الشافعي، كمال الدين محمّد(ت652هـ/1254م):
361. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، تح: ماجد بن أحمد العطية، د.م، د.ت.
362. الطوسي، أبو جعفر محمّد بن الحسن(ت460هـ/1067م):
363. رجال الطوسي، تح: جواد الفيومي، الاصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1415هـ.
364. الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود(ت204هـ/819م):
365. مسند أبي داود الطيالسي، تح: محمّد عبد المحسن، دار هجر، مصر، 1999م.
366. ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر(ت280هـ/893م):
367. بلاغات النساء، صحّحه: أحمد الالفي، القاهرة، 1908م.
368. (ع)
369. ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمر(ت287هـ/900م):
370. الآحاد والمثاني، تح: باسم فيصل أحمد الجوايرة، دار الراية، الرياض، 1991م.
371. السنّة، تح: محمّد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 1400هـ.
372. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله(ت463هـ/1070م):
373. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تح: علي محمّد البجاوي، دار الجيل، بيروت، 1992م.
374. ابن عبد الحقّ، عبد المؤمن بن عبد الحقّ بن شمائل القطيعي (ت739هـ/1338م):
375. مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، دار الجيل، بيروت، 1412هـ.
376. ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن(ت257هـ/870م):
377. فتوح مصر وأخبارها، تح: محمّد الحجيري، دار الفكر، بيروت، 1996م.
378. ابن عبد الحكم، أبو محمّد عبد الله(ت214هـ/829م):
379. سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه، صحّحه: أحمد عبيد، دار العلم للملايين، ط5، بيروت، 1967م.
380. ابن عبد ربّه، شهاب الدين أحمد بن محمّد(ت328هـ/939م):
381. طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار، مكتبة القرآن، القاهرة، د.ت.
382. العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت 1404هـ.
383. ابن العبري، أبو الفرج غريغويوس بن هارون الملطي(ت685هـ /1286م):
384. تاريخ مختصر الدول، انطون صالحاني اليسوعي، دار الشرق، بيروت، 1992م.
385. ابو عبيد، القاسم بن سلام بن عبد الله، (224هـ/838م):
386. الأموال، تح: خليل محمّد هراس، دار الفكر، بيروت، د.ت.
387. العبيدلي، يحيى بن الحسن بن جعفر(ت277 هـ/890م):
388. أخبار الزينبيّات، تح: حسن محمّد، ط2، مصر، 1934م.
389. ابن عثمان الشارعي، موفق الدين بن محمّد بن عبد الرحمن (ت615هـ /1218م):
390. مرشد الزوار إلى قبور الأبرار، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 1415هـ.
391. ابن عدي، أبو أحمد عبد الله بن عدي(ت365هـ/975م):
392. الكامل في ضعفاء الرجال، تح: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمّد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
393. ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله(ت660هـ/1209م):
394. بغية الطالب في تاريخ حلب، تح: سهيل زكار، دار الفكر، د.م، د.ت.
395. ابن العراقي، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين(ت826هـ/1422م):
396. المدلّسين، تح: رفعت فوزي عبد المطلب ونافد حسين حماد، دار الوفاء، د.م، 1995م.
397. أبو العرب التميمي، محمّد بن أحمد بن تميم(ت 333هـ/944م):
398. المحن، تح: عمر سلمان العقيلي، دار العلوم، الرياض، 1984م.
399. ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسين(ت571هـ/1175م):
400. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنو حيّها من وارديها وأهلها، تح: عمر بن عوادة العمري، دار الفكر، د.م، 1995م.
401. العصامي، عبد الملك بن حسين الملك(ت1111هـ /1699م):
402. سمط النجوم في أبناء الأوائل والتوالي، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، دار الكتب العلية، بيروت، 1988م.
403. ابن عطية الأندلسي، أبو محمّد عبد الحقّ(ت542هـ/1147م):
404. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي محمّد، دار الكتب العلمية، لبنان، 1993م.
405. العقيلي، محمّد بن عمر بن موسى(ت322هـ/933م):
406. الضعفاء، تح: مازن السرساوي، دار ابن عباس، ط2، مصر، 2008م.
407. ابن عماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد بن محمّد(ت1089هـ/1678):
408. شذرات ذهب في أخبار من ذهب، تح: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت، 1986م.
409. العمري، علي بن محمّد بن علي (ت:709هـ/1309م):
410. المجدي في أنساب الطالبيين، تح: أحمد المهدوي الدامغاني، مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، 1409هـ.
411. ابن عنبة، السيد جمال الدين أحمد بن علي(ت 828هـ/1424م):
412. عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، دار الأندلس، النجف، د.ت.
413. (غ)
414. ابن الغزّي، محمّد بن عبد الرحمن(ت1167هـ/1753م):
415. ديوان الإسلام، تح: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.
416. (ف)
417. الفاكهي، أبو عبد الله محمّد بن اسحاق(ت272هـ/885م):
418. أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه، تح: عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر، ط2، بيروت، 1414هـ.
419. ابن الفتّال النيسابوري، محمّد بن أحمد بن علي(ت 508هـ/1114م):
420. روضة الواعظين وبصيرة المتعظين، تقديم: محمّد مهدي السيد حسن الخرساني، منشورات الشريف الرضي، د.م، د.ت.
421. أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل(ت732هـ/1331م):
422. المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية، د.م، د.ت.
423. ابن الفرّاء، أبو بكر عتيق الغساني(ت698هـ/1298م):
424. نزهة الأبصار في فضائل الأنصار، تح: عبد الرزاق بن محمّد، أضواء السلف، د.م، 2004م.
425. الفراهيدي، أبو عبد الله الرحمن بن الخليل(ت170هـ/786م):
426. العين، تح: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، د.م، د.ت.
427. أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمّد(ت356هـ/966م):
428. الأغاني، تح: سمير جابر، دار الفكر، ط2، بيروت، د.ت.
429. مقاتل الطالبيين، تح: أحمد صقر، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
430. الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان(ت347 هـ/890م):
431. المعرفة والتاريخ، تح: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
432. أبو الفضل الميداني، أحمد بن محمّد بن إبراهيم، (518هـ/1124م):
433. مجمع الأمثال، تح: محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
434. الفيروز أبادي، مجد الدين أبو طاهر، (817هـ/1414م):
435. القاموس المحيط، تح: مكتبة التراث، إشراف: محمّد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، ط8، بيروت، 2005م.
436. الفيض الكاشاني، محمّد بن محسن(ت1091هـ/1680م):
437. الوافي، تح: ضياء الدين الحسني، د.م، د.ت.
438. الفيومي، أحمد بن محمّد بن علي(ت770هـ/1368م):
439. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، د.ت.
440. (ق)
441. القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى(ت544هـ/1149م):
442. الشفا بتعريف حقوق المصطفى مذيلا بالحاشية المسماة: مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، حاشية: أحمد به محمّد بن محمّد، دار الفكر، د.م، 1988م.
443. القاضي النعمان، أبو حنيفة النعمان بن محمّد المغربي، (363هـ /973م):
444. شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار^، تح: محمّد حسيني الجلالي، مؤسسة النشر الإسلامية، قم، د.ت.
445. القالي، اسماعيل بن القاسم بن عبدرون(ت356هـ/966م):
446. الأمالي، ترتيب: محمّد عبد الجواد الاصمعي، دار الكتب المصرية، ط2، مصر، 1926م.
447. ابن قتيبة الدينوري، أبو محمّد عبد الله بن مسلم(ت276هـ/889م):
448. الإمامة والسياسة، تح: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
449. الشعر والشعراء، دار الحديث، القاهرة، 1423هـ.
450. المعارف، تح: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة، ط2، القاهرة، 1992م.
451. عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ.
452. ابن قدامة، عبد الرحمن أبي عمر بن أحمد(ت682هـ/1283م):
453. الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
454. ابن قدامة، أبو محمّد عبد الله بن أحمد(ت620هـ/1223م):
455. المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.
456. القزويني، زكريا بن محمّد بن محمود(ت682هـ/1283م):
457. آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، ، بيروت، د.ت.
458. القسطلاني، أحمد بن محمّد بن أبي بكر(ت 923هـ/1516م):
459. المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، المكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت.
460. القضاعي، أبو عبد الله محمّد بن سلامة(ت454هـ / 1062م):
461. ، مسند الشهاب، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1986م.
462. القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف(ت646هـ/1248م):
463. إنباه الرواة على أنباء النحاة، المكتبة العنصرية، بيروت، 1424هـ.
464. القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي(ت821هـ/1418م):
465. مآثر الأناقة في معالم الخلافة، تح: عبد الستار أحمد فراج، وزارة الإرشاد والأبناء، الكويت، 1964م.
466. -ابن قنفذ، أبو العباس أحمد(ت810هـ/1407م):
467. الوفيّات معجم زمني للصحابة والمحدّثين والفقهاء والمؤلفين، تح: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، ط4، بيروت، 1983م.
468. ابن قولويه، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن جعفر بن موسى (ت367هـ/977م):
469. كامل الزيارات، تح: جواد الفيومي، مؤسسة النشر الإسلامي، د.م، 1417هـ.
470. القونوي، قاسم بن عبد الله الحنفي(ت978هـ/1570م):
471. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تح: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، د.م، 2004م.
472. القيرواني، إبراهيم بن علي بن تميم(ت453هـ/1061م):
473. زهر الآداب وثمر الألباب، تح: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
474. ابن قيم الجوزية، محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد(ت751هـ/ 1350م):
475. أحكام أهل الذمّة، تح: طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 2002م.
476. أخبار النساء، منشورات مكتبة التحرير، د.م، د.ت.
477. (ك)
478. الكتبي، محمّد بن شاكر بن أحمد(ت764هـ/1362م):
479. فوات الوفيّات، تح: احسان عباس، دار صادر، بيروت، 1974م.
480. ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر(ت774هـ/1372م):
481. البداية والنهاية، تح: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1988م.
482. جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن، تح: عبد الملك بن عبد الله الدهيش، دار خضر، مكّة المكرّمة، 1998م.
483. ابن كرامة، شرف الإسلام بن سعيد(ت494هـ/1100م):
484. تنبيه العاملين عن فضائل الطالبين، تح: تحسين آل شيبة، مركز الغدير لدراسات الإسلامية، د.م، 1420هـ.
485. الكفعمي، تقي الدين إبراهيم(ت905هـ/1498م):
486. جنّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية المشتهر بالمصباح، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط3، بيروت، 1983م.
487. الكلاباذي، أبو بكر محمّد بن أبي اسحاق(ت380هـ/990م):
488. بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، تح: محمّد حسن محمود وأحمد مزيد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1999م.
489. الكندي، أمرئ القيس بن حجر بن الحارث(ت80 ق هـ):
490. ديوان امرئ القيس، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط2، بيروت، 2004م.
491. ابن الكيال، أبو البركات محمّد بن أحمد، (950هـ/1543م):
492. الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات، تح: عبد القيوم عبد ربّ النبي، دار المأمون، بيروت، 1981م.
493. اللاكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن(ت418هـ/1028م):
494. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تح: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار الطيبة، ط8، السعودية، 2003م.
495. كرامات الأولياء للالكائي، تح: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، ط8، السعودية، 2003م.
496. (م)
497. ابن ماجة، أبو عبد الله محمّد بن زيد(ت273 هـ /886م):
498. سنن ابن ماجة، تح: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، د.م، د.ت.
499. المازندراني، محمّد بن اسماعيل(ت1216هـ/1801م):
500. منتهى المقال في أحوال الرجال، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1416هـ.
501. ابن مأكولا، أبو نصر علي بن هبه الله(ت475هـ/1082م):
502. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م.
503. المالقي، أبو عبد الله بن محمّد بن يحيى (ت741هـ/1340م):
504. التمهيد والبيان في المقاتل الشهيد عثمان، تح: محمود يوسف زايد، دار الثقافة، دوحة، 1405هـ.
505. الماوردي، أبو الحسن علي بن محمّد(ت450هـ/1058م):
506. النكت والعيون، تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، د.م.
507. أبن المبرّد، أبو العباس محمّد بن يزيد(ت285هـ/899م):
508. الكامل في اللغة والأدب، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط3، القاهرة، 1997م.
509. المتّقى الهندي، علاء الدين علي(ت 975هـ/1567م):
510. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تح: بكري حياني صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ط5، د.م، 1981م.
511. المجلسي، محمّد باقر بن تقي(ت1111هـ/1699م):
512. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، تح: محمّد باقر البهبودي، مؤسسة الوفاء، ط2، بيروت، 1983م.
513. محبّ الدين الطبري، أحمد بن عبد الله بن محمّد(ت694هـ/1294م):
514. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، مكتبة القدسي، القاهرة، 1356هـ.
515. الرياض النضرة في مناقب العشرة، دار الكتب العلمية، د.م، د.ت.
516. أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد بن خلف(ت157هـ/773م):
517. مقتل الحسين^ ومصرع أهل بيته وأصحابه في كربلاء، المشتهر بمقتل أبي مخنف، تح: ميرزا حسن الغفاري، المكتبة العامة للسيد شهاب الدين المرعشي النجفي، قم، 1398هـ.
518. المرزباني، أبو عبد الله محمّد بن عمروان(ت384هـ/994م):
519. مختصر أخبار شعراء الشيعة، تح: محمّد هادي الأميني، بيروت، 1993م.
520. معجم الشعراء، تح: ف. كرنكو، دار الكتب العلمية، ط2، بيروت، 1982م.
521. الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدّة أنواع من صناعة الشعر، تح: علي محمّد البجاوي، دار النهضة، مصر، د.ت.
522. المرسي، أبو الحسن علي بن إسماعيل(ت458هـ/1065م):
523. المحكم والمحيط والأعظم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.
524. ابن المستوفي، المبارك بن أحمد بن المبارك(ت376هـ/986م):
525. تاريخ اربل، تح: سامي بن سيد خماس الصقار، دار الرشيد للنشر، العراق، 1980م.
526. المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسن(ت346هـ/957م):
527. إثبات الوصية، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، د.ت.
528. أخبار الزمان ومَن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران، دار الاندلس، بيروت، 1996م.
529. التنبيه والإشراف، تح: عبد الله اسماعيل الصاوي، دار الصاوي، القاهرة، د.ت.
530. مروج الذهب ومعادن الجوهر، منشورات دار الهجرة، ط2، قم، 1984م.
531. مسكوية، أبو علي أحمد بن محمّد(ت421هـ/1030م):
532. تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تح: أبو القاسم إمامي، دار مروش، ط2، طهران، 2000م.
533. المشغري، يوسف بن حاتم الشامي(ت664هـ/1265م):
534. الدرر النظيم، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، د.ت.
535. المشهدي، أبو عبد الله محمّد بن جعفر(ت ق 6 هـ/12م):
536. المزاد الكبير، تح: جواد القيومي الاصفهاني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1419هـ.
537. ابن المعتز، عبد الله بن محمّد(ت296هـ/908م):
538. البديع في البديع، دار الجيل، د.م. 1990م.
539. المعتزلي، القاضي عبد الجبار بن أحمد(ت415هـ/124م):
540. تثبيت دلائل النبوة، دار المصطفى، القاهرة، د.ت.
541. ابن المغازي، علي بن محمّد بن محمّد بن الطيب(ت483هـ/1090م):
542. مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دار الآثار، صنعاء، 2003م.
543. المفضل بن سلمة، أبو طالب بن عاصم(ت290هـ/902م).
544. الفاخر، تح: عبد العليم الطحاوي، مراجعة: محمّد علي النجر، دار إحياء الكتاب العربي، د.م، 1380هـ.
545. المفيد، ابن عبد الله محمّد بن محمّد(ت413هـ/1022م):
546. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، دار المفيد، ط2، بيروت، 1993م.
547. المقدسي، المطهّر بن طاهر(ت355هـ/965م):
548. البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد، د.ت.
549. المقري، أحمد بن محمّد بن امد(ت1041هـ/1631م):
550. نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيره السان الدين الخطيب، تح: احسان عباس، دار صادر، بيروت، 1997م.
551. المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي(ت845هـ/1441م):
552. إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تح: محمّد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1999م.
553. مختصر الكامل في الضعفاء، تح: أيمن ارف الدمشقي، مكتبة السنة، القاهرة، 1994م.
554. المناوي، زين الدين محمّد(ت 1031هـ/1621م):
555. التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي، ط3، الرياض، 1988م.
556. المنجم، اسحاق بن الحسين(ت ق 4هـ/10م):
557. آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان، عالم الكتب، بيروت، 1408هـ.
558. ابن منجوية، أحمد بن علي بن محمّد(ت428 هـ/1036م):
559. رجال صحيح مسلم، تح: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، 1407هـ.
560. ابن مندة، أبو عبد الله محمّد بن إسحاق(ت395هـ/1004م):
561. فتح الباب في والكنى والألقاب، تح: أبو قتيبة، مكتبة الكوثر، الرياض، 1996م.
562. ابن منظور، محمّد بن مكرم(ت711هـ/1311م):
563. لسان العرب، دار صادر، ط3، بيروت، 1414هـ.
564. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، تح:روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد ومحمد مطيع، دار الفكر، دمشق، 1984م.
565. ابن منقذ، اسامه بن مرشد بن علي، (584هـ/1188م):
566. البديع في نقد الشعر، تح: أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، د.م، د.ت.
567. المنقري، نصر بن مزاحم(ت212هـ/827م):
568. واقعة صفين، تح: عبد السلام محمّد هارون، المؤسسة العربية الحديثة، ط2، د.م.
569. المؤيد، يحيى بن علي بن إبراهيم(ت745 هـ/1344م):
570. الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العنصرية، بيروت، 1423م. (ن)
571. ابن النديم، أبو فرج محمّد بن اسحاق(ت438هـ/1046م):
572. الفهرست، تح: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، ط2، بيروت، 1997م.
573. النراقي، أحمد بن محمّد مهدي(ت1245هـ/1829م):
574. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم، 1418هـ.
575. النسائي، أبو عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب(ت303هـ/915م):
576. السنن الكبرى، تح: حسن عبد المنعم، الشلبي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001 م.
577. ابن نشوان، محمّد نشوان بن سعيد(ت 573هـ/1177م):
578. الحور العين، تح: كمال مصطفى، مكتبة الخارجي، القاهرة، 1998م.
579. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تح: حسين عبد الله العمري ومظهر بن علي ويوسف محمّد عبد الله، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت ودمشق، 1999م.
580. أبو نصر البخاري، سهل بن عبد الله بن داود، (كان حيا 341هـ/ 952م):
581. سر السلسلة العلوية، علّق عليه: سيد محمّد صادق بحر العلوم، إنتشارات الشريف الرضي، نجف، 1962م.
582. أبو نصر الكشي، أبو محمّد عبد الحميد بن حميد(ت249هـ/863م):
583. المنتخب من مسند عبد الحميد، تح: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمّد الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، 1988م.
584. أبو نصر الكلاباذي، أحمد بن محمّد بن الحسن(ت398هـ/1007م):
585. الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، تح: عبد الله الليثي، دار المعرفة، بيروت، 1407هـ.
586. النعماني، ابن أبي زينب محمّد بن إبراهيم(ت380هـ/990م):
587. كتاب الغيبة، تح: علي أكبر الغفاري، مكتبة الصدوق، طهران، د.ت.
588. أبو نعيم الاصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت430هـ/1038م):
589. معرفة الصحابة، تح: عادل يوسف، دار الوطن، الرياض، د.ت.
590. النعيمي، عبد القادر بن محمّد، (927هـ/1520م):
591. الدارس في تأريخ المدارس، تح: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، د.م، 1990م.
592. نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول(ت ق12هـ/18م):
593. دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)، تعريب: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، بيروت، 2000م.
594. ابن نما الحلي، نجم الدين محمّد بن جعفر (ت 645هـ/1247م):
595. ذوب النضار في شرح الثار، تح: فارس حسون كريم، مؤسسة النشر الإسلامي، د.م، 1416هـ.
596. مثير الأحزان، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، 1950م.
597. النووي، أبو زكريا محي الدين(ت676هـ /1277م):
598. تهذيب الأسماء واللغات، تصحيح: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
599. النويري، أحمد بن عبد الوهاب(ت733هـ/1332م):
600. نهاية الأرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 1423هـ.
601. النيسابوري، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري(ت261هـ/ 874م):
602. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله|، تح: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.
603. أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل(ت395هـ/ 1004م):
604. الأوائل، دار البشير، طنطا، 1408هـ.
605. الهلالي، أبو صادق سليم بن قيس(ت76هـ/695م):
606. كتاب سليم بن قيس الهلالي، تح: محمّد باقر الانصاري، ط2، قم، 1424هـ.
607. الهمذاني، أبو بكر محمّد بن موسى(ت 584هـ/1188م):
608. الأماكن أو ما اتفق لفظه أو افترق مسمّاه من الأمكنة، تح: حمد بن محمّد الجاسر، دار اليمامة، د.م، 1415هـ.
609. الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر(ت807هـ/1404م):
610. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1988م.
611. الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد(ت468هـ/1075م):
612. أسباب نزول القرآن، تح: عصام بن عبد المحسن، دار الإصلاح، ط2، الدمام، 1992م.
613. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تعليق وتح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض واحمد محمّد صيره وأحمد عبد الغني الجمل وعبد الرحمن عويس، قدّمه: عبد الحي الفرماني، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994م.
614. الوحش، عبد الله بن بري بن عبد الجبّار(ت852هـ/1448م):
615. في التعريب والمعرب، تح: إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، د.ت.
616. ابن الوردي، عمر بن مظفر بن عمر بن محمّد(ت749هـ/1349م):
617. تاريخ بن الوردي، بيروت، 1996م.
618. (ي)
619. اليافعي، عبد الله بن أسعد بن علي(ت 768هـ/1366م):
620. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، وضع حواشيه، خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1997م.
621. ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي (ت626هـ/1228م):
622. معجم الأدباء، تح: احسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1993م.
623. معجم البلدان، دار صادر، ط2، بيروت، 1995م.
624. يحشل، أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب(ت292هـ/904م):
625. تاريخ واسط، تح: كوركيس عواد، عالم الكتب، بيروت، 1406هـ.
626. اليعقوبي، أحمد بن اسحاق(ت292هـ/904م):
627. البلدان، دار الكتب العلمية، بيروت، 1422هـ.
628. أبو يعلي، أحمد بن علي بن المثنى(ت307هـ/919م):
629. مسند أبي يعلي، تح: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 1984م.
630. ابن يونس، عبد الرحمن بن أحمد(ت347هـ/958م):
631. تاريخ ابن يونس المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421هـ.
ثانيا: المراجع الثانوية
|
(أ) |
|
|
- |
إبراهيم، ريكان: |
|
1. |
نقد الشعر في المنظور النفسي، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1989م. |
|
- |
الابطحي، مرتضى: |
|
2. |
الشيعة في أحاديث فريقين، مطبعة الأمير، د.م، 1416هـ. |
|
- |
أرفع، فاطمة السادات: |
|
3. |
معجم الشاعرات النبي| وأهل بيته^ في القرنين الأول والثاني الهجريين، د.م، د.ت. |
|
- |
اسماعيل، عِزّ الدين: |
|
4. |
المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، دار النهضة العربية، بيروت، 1976م. |
|
5. |
اسماعيل، علي فهمي، مدخل إلى علم النفس العام، المكتب الجامعي الحديث، د.م، 1985م. |
|
- |
الاعرابي، إبراهيم: |
|
6. |
ديوان عمر بن أبي ربيعة، مكتبة صادر، بيروت، د.ت. |
|
- |
أمين، أحمد: |
|
7. |
فجر إسلام يبحث عن الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية، مكتبة النهضة المصرية، ط9، د.م، 1964م. |
|
8. |
النقد الأدبي، دار الكتاب العربي، ط4، بيروت، 1967م. |
|
- |
الأمين، محسن، (1371هـ/1951م): |
|
9. |
أصدق الأخبار في قصّة الأخذ بالثار، منشورات مكتبة بصيرتي، قم، 1331هـ. |
|
10. |
أعيان الشيعة، تح: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، د.ت. |
|
- |
الأميني، عبد الحسين أحمد: |
|
11. |
الغدير في الكتاب والسنة والأدب، دار الكتاب العربي، ط4، بيروت، 1977م. |
|
- |
الأميني، محمّد أمين: |
|
12. |
الأيام الشامية من عمر النهضة الحسينية، دار الولائي، بيروت، 2006م. |
|
- |
الأنباري، عبد الرزاق علي العمران: |
|
13. |
تاريخ الدولة العربية العصر الراشدي والأموي، سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة، ط2، بغداد، 2012م. |
|
(ب) |
|
|
- |
بابتي، عزيزة فوال: |
|
14. |
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين، دارصادر، بيروت، 1998م. |
|
- |
باسلوم، مجدي محمّد سرور، وسميرة جميل مسكي: |
|
15. |
موسوعة آل بيت النبي، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت. |
|
- |
البحراني، هاشم: |
|
16. |
مدينة المعاجز، تح: عِزّ الله المولائي، مؤسسة المعارف الإسلامية، د.ت، 1413م. |
|
- |
البرجودي، محمّد شفيع الجابلقي، (1313هـ/1895م): |
|
17. |
طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، تح: مهدي الرجائي، مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم. د.ت. |
|
- |
البستاني، سليمان بن خطار بن سلوم: |
|
18. |
أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، دار مارون عبود، د.م، د.ت. |
|
19. |
كتاب دائرة المعارف، مطبعة الأدبية، بيروت، 1887م. |
|
- |
البلداوي، عدنان عبد النبي: |
|
20. |
سكينة بنت الحسين÷ نبراس هزم الافتراء، دار حامد الإبراهيمي، بغداد، د.ت. |
|
- |
البياتي، جعفر: |
|
21. |
الأخلاق الحسينية، أنوار الهدى، د.م، 1418هـ. |
|
- |
البيروتي، بشير يموت: |
|
22. |
شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، مكتبة الأهلية، بيروت، 1934م. |
|
- |
بيضون، إبراهيم: |
|
23. |
التوابون، د.مط، د.م، د.ت. |
|
- |
بيضون، لبيب: |
|
24. |
موكب الإباء من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، مؤسسة البلاغ، بيروت، 2009م. |
|
25. |
موسوعة كربلاء، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 2006م. |
|
(ت) |
|
|
- |
التستري، جعفر: |
|
26. |
الأيام الحسينية، ترجمة: إبراهيم رفاعة، دار المرتضى، بيروت، 1993م. |
|
(ج) |
|
|
- |
جبور، جبرائيل سليمان: |
|
27. |
عصر عمر بن أبي ربيعة، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 1935م. |
|
- |
جعفر، مرتضى: |
|
28. |
مأساة الزهراء‘ (شبهات... وردود)، دار السيرة، بيروت، 1997م. |
|
- |
الجلالي، محمّد حسين الحسيني: |
|
29. |
فهرس التراث، تح:محمد جواد الحسيني، قم، 1422هـ. |
|
30. |
مزارات أهل البيت وتاريخها، بيروت، 1995م. |
|
- |
الجلالي، محمّد رضا: |
|
31. |
الإمام الحسين× سماته وسيرته، دار المعروف، قم، د.ت. |
|
- |
الجميلي، علي إبراهيم عبيد: |
|
32. |
مسلم بن عقيل× دراسة تاريخية، دار المتقين، بيروت، 2011م. |
|
- |
الجواهري، محمّد حسن النجفي، (1266هـ/1849م): |
|
33. |
جواهر الكلام في شرح الإسلام، تح: عباس القوجاني، دار الكتب الإسلامية، ط2، طهران، 1365ش. |
|
- |
أبو جيب، سعدي: |
|
34. |
القاموس الفقهي، دار الفكر، ط2، دمشق، 1988م. |
|
(ح) |
|
|
- |
الحائري، جعفر: |
|
35. |
معالم الإنسانية في نهضة الإمام الحسين×، مؤسسة البلاغ، ط2، بيروت، 2007م. |
|
- |
الحائري، محمّد حسين الأعلمي: |
|
36. |
تراجم أعلام النساء، مؤسسة الأعلمي، ، بيروت، 1987م. |
|
- |
حاتم، نوري: |
|
37. |
الحياة السياسية للإمام السجاد×، مؤسسة المرتضى العلمية، بيروت، 1994م. |
|
- |
الحداد، كفاح: |
|
38. |
نساء الطفوف، تقديم: السيد محمّد علي الحلو، العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء، 2011م. |
|
- |
الحربي، عاتق بن غيث بن زوير: |
|
39. |
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، دار مكّة لتوزيع، مكّة المكرمة، 1982م. |
|
- |
الحسن، عبد الله: |
|
40. |
ليلة عاشوراء في الحديث والأدب، مطبعة بهن، د.م، 1418هـ. |
|
|
الحسين، قصي: |
|
41. |
تجديد الدولة العربية زمن الأمويين، الشركة العالمية للكتب، لبنان، 1997م. |
|
- |
الحسيني، هاشم معروف: |
|
42. |
تاريخ الفقه الجعفري، تح: محمّد جاد مغنية، دار النشر للجامعيين، د.ت، د.م. |
|
43. |
من وحي الثورة الحسينية، دار التعارف، سوريا، 1994م. |
|
- |
الحكيم، محمّد باقر: |
|
44. |
الإمام الحسين×، مطبعة العترة الطاهرة، النجف الأشرف، 2008م. |
|
- |
الحلو، محمّد علي: |
|
45. |
تاريخ الحديث النبوي بين سلطة النصّ ونصّ السلطة، مكتبة الإمام الصادق×، ط5، النجف، د.ت. |
|
46. |
عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة، مؤسسة السبطين÷ العالمية، ط2، قم، 1424هـ. |
|
- |
حنفي، حسين: |
|
47. |
من العقيدة إلى الثورة، دار التنوير، بيروت، 1988م. |
|
- |
الحنفي، علي محمّد فتح الدين: |
|
48. |
فلك النجاة في الإمامة والصلاة، تح: ملا أصغر علي محمّد، مؤسسة دار الإسلام، ط2، د.م، 1997م. |
|
(خ) |
|
|
- |
خالد، محمّد خالد: |
|
49. |
أبناء الرسول في كربلاء، دار ثابت لنشر والتوزيع، ط5، القاهرة، 1986 م. |
|
- |
الخربوطلي، علي حسيني: |
|
50. |
تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي السياسي والاجتماعي والاقتصادي، دار التعارف، مصر، 1956م. |
|
- |
الخرسان، محمّد مهدي: |
|
51. |
موسوعة عبد الله بن عباس (حبر الأمة وترجمان القرآن)، مركز الأبحاث العقائدي، قم، د.ت. |
|
- |
الخطيب، بشرى محمّد علي: |
|
52. |
الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، مطبعة الإدارة المحلية، بغداد، 1977م. |
|
- |
الخوئي، حبيب الله الهاشمي(ت1324هـ/1906م): |
|
53. |
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تصحيح: إبراهيم الميانجي، منشورات دار الهجرة، ط4، قم، د.ت. |
|
- |
الخوئي، أبو القاسم الموسوي: |
|
54. |
معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ط5، د.م، 1992م. |
|
- |
الخياط، جلال: |
|
55. |
تاريخ الأدب العربي الحديث، مطبعة الشعب، ط3، بغداد، 1962م. |
|
(د) |
|
|
- |
دكسن، عبد الأمير عبد حسين: |
|
56. |
الخلافة الأموية (65هـ - 86هـ/684م – 705 م) دراسة سياسية، جامعة بغداد، بغداد، 1973م. |
|
- |
الدلفي، ملا رجي: |
|
57. |
سطور مع نساء مؤمنات، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، د.ت. |
|
- |
دهمان، محمّد أحمد: |
|
58. |
معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، بيروت وسوريا، 1990م. |
|
- |
الدوري، عبد العزيز: |
|
59. |
مقدّمة في تاريخ صدر الإسلام، مطبعة المعارف، بغداد، 1949م. |
|
- |
الديوه جي، سعيد: |
|
60. |
عقائل قريش، المطبعة العصرية، ط2، الموصل، 1955م. |
|
(ر) |
|
|
- |
الرافعي، مصطفى صادق: |
|
61. |
تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، د.م، د.ت. |
|
- |
الراوي، ثابت اسماعيل: |
|
62. |
العراق في العصر الأموي من الناحية السياسية والأدارية والاجتماعية، منشورات مكتبة الأندلس، بغداد، 1971م. |
|
- |
الريس، محمّد ضياء الدين: |
|
63. |
عبد الملك بن مروان والدولة الأموية، مطابع سجل العرب، ط2، د.م، 1969م. |
|
- |
الري شهري، محمد: |
|
64. |
أهل البيت في الكتاب السنة، دار الحديث، ط2، د.م، 1375ش. |
|
65. |
مميزات الحكمة، دار الحديث، د.ت، د.م. |
|
(ز) |
|
|
- |
الزركلي، خير الدين بن محمود: |
|
66. |
، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، ط15، د.م، 2002م. |
|
- |
زميزم، سعيد شيد: |
|
67. |
نساء حول الحسين×، مراجعة وتح: محمّد صادق التاج، دار الجوادين، د.م، 2011م. |
|
- |
زيدان، جرجي: |
|
68. |
تاريخ آداب اللغة العربية، مكتبة الحياة، د.م، 1992م. |
|
69. |
تاريخ التمدّن الإسلامي، مطبعة الهلال، ط 3، مصر، 1920م.
|
|
(س) |
|
|
- |
الساعدي، حسين: |
|
70. |
المعلى بن خنيس شهادته ووثاقته ومسنده، دار الحديث، قم، 1383ش. |
|
- |
سالم، السيد عبد العزيز: |
|
71. |
تاريخ الدولة العربية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، 1973م. |
|
- |
السامرائي، أحمد عبد الغفور: |
|
72. |
فقهاء اهل البيت في عصر الخلافة الراشدة والعصر الأموي، مطبعة أنوار دجلة، بغداد، 2006م. |
|
- |
أبو سعيدة، السيد حسن: |
|
73. |
بنات المعصومين دراسة وتوثيق، مؤسسة البلاغ، بيروت، 2012م. |
|
- |
السقاف، حسن بن علي: |
|
74. |
قاموس شتائم، دار الإمام النووي، عمّان، 1999م. |
|
- |
سلوم، داود: |
|
75. |
دراسة كتاب الأغاني ومنهج مؤلِّفه، عالم الكتب، ط3، بيروت، 1985م. |
|
- |
السماوي، محمّد بن طاهر: |
|
76. |
إبصار العين في أنصار الحسين×، تح: محمّد جعفر الطبسي، مركز الدراسات الإسلامية، د.ت، 1419هـ. |
|
(ش) |
|
|
- |
بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن: |
|
77. |
سكينة بنت الحسين، دار الكتاب العربية، بيروت، د.ت. |
|
- |
الشاكري، حسين: |
|
78. |
شهداء أهل البيت^ قمر بني هاشم، مطبعة ستارة، د.م، 1420هـ. |
|
79. |
العقيلة والفواطم، مطبعة ستارة، قم، د.ت. |
|
80. |
موسوعة المصطفى والعترة^ (الإمام محمّد الباقر×)، دار الهادي، قم، 1417هـ. |
|
- |
الشاهرودي، علي النمازي: |
|
81. |
مستدركات علم رجال الحديث، مطبعة حيدري، طهران، د.ت. |
|
- |
الشبستري، عبد الحسين: |
|
82. |
مشاهير شعراء الشيعة، المكتبة الأدبية المخصة، قم، 1431هـ. |
|
- |
شراد، محمد: |
|
83. |
موسوعة نساء شاعرات، تح: حيدر امل، دار مكتبة الهلال، بيروت، 2006م. |
|
- |
الشريف الكاشاني، ملا حبيب الله(ت1340هـ/1921م): |
|
84. |
ذريعة الاستغناء في تحقيق مسألة الغناء، كتب الإعلام الإسلامي، قم، 1417هـ. |
|
- |
الشريفي، محمود، وحسن سجادي تبار وعلي الغلامي وبهاء الدين قهرمان نزاد: |
|
85. |
موسوعة كلمات الامام الحسين^، دار المعروف، ط3، د.م، 1995م. |
|
- |
شمس الدين، محمّد مهدي: |
|
86. |
أنصار الحسين^، الدار الإسلامية، ط2، د.م، 1981م. |
|
- |
الشهرستاني، هبة الدين الحسيني: |
|
87. |
نهضة الحسين^، بغداد، 1343هـ. |
|
- |
شيخاني، سمير: |
|
88. |
نساء، دار الجيل، بيروت، 1993م. |
|
- |
الشيرازي، محمّد الحسيني: |
|
89. |
صلح الإمام الحسن، مؤسسة المجتبى، ط2، كربلاء المقدسة، 2004م. |
|
(ص) |
|
|
- |
الصدر، محمّد محمد صادق: |
|
90. |
أضواء على ثورة الإمام الحسين^، ط 2، النجف، د.ت. |
|
91. |
شذرات من فلسفة تاريخ الحسين^، تح: الشيخ أسعد الناصري، اصدارات مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد الشهيد محمّد الصدرu، النجف، 1428هـ. |
|
- |
الصفّار، حسن موسى: |
|
92. |
المرأة العظيمة قراءة في حياة السيّدة زينب بنت علي÷، الانتشارات العربي، د.م، 2010م. |
|
- |
صفوت، أحمد زكي: |
|
93. |
جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة، المكتبة العالمية، بيروت، د.ت. |
|
(ض) |
|
|
- |
ضيف، شوقي: |
|
94. |
الشعر والغناء في المدينة ومكّة لعصر بني أمية، دار المعارف، ط3، مصر، د.ت. |
|
(ط) |
|
|
- |
الطاهر، علي جواد: |
|
95. |
مقدّمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1979م. |
|
- |
الطبراني، عبد العظيم المهتدي: |
|
96. |
من أخلاق الإمام الحسين× (دروس في السلوك والتربية وقيم الحياة الطيبة)، انتشارات شريف الرضي، قم، 2000م. |
|
- |
الطبرسي، حسين النوري، (1320هـ/1902م): |
|
97. |
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تح: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، بيروت، 1988م. |
|
- |
الطبرسي، محمّد جعفر: |
|
98. |
وقائع الطريق من كربلاء إلى الشام، قم، 1382هـ. |
|
- |
طه، عبد الواحد ذنون: |
|
99. |
العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي من الناحية السياسية والإدارية 75 – 95 هـ، اللجنة الوطنية، د.م، 1985م. |
|
(ع) |
|
|
- |
العاملي، جعفر مرتضى: |
|
100. |
علي× والخوارج (تاريخ ودراسة)، المركز الإسلامي للدراسات، بيروت، 2000م.
|
|
- |
العاملي، علي الكوراني: |
|
101. |
جواهر التاريخ، دار الهدى، د.م، 1427هـ. |
|
- |
العاملي، محسن الأمين: |
|
102. |
لواعج الأشجان في مقتل الحسين، منشورات مكتبة بصيرتي، قم، 1331هـ. |
|
- |
عبد الحميد، محمّد محي الدين: |
|
103. |
شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار الأندلس، بيروت، 1997م. |
|
- |
عبد اللطيف، عبد الشافي حمد: |
|
104. |
السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، دار السلام، القاهرة، 1428هـ. |
|
- |
عبد المنعم، محمود عبد الرحمن: |
|
105. |
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، د.م، د.ت. |
|
- |
عبد الهادي، يوسف: |
|
106. |
ثمار المقاصد في ذكر المساجد، مكتبة لبنان، د.م، 1975م. |
|
- |
العبود، نافع توفيق: |
|
107. |
آل المهلّب بن أبي صفرة ودورهم في التاريخ حتى منتصف القرن الرابع الهجري، مطبعة جامعة بغداد، بغداد، 1979م. |
|
- |
عتيق، عبد العزيز: |
|
108. |
تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربية، بيروت، 1974م. |
|
- 109. |
عثمان، هاشم: مشاهد ومزارات آل البيت^ في الشام، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1994م. |
|
- |
عزوز، إبراهيم: |
|
110. |
تاريخ العصر الأموي السياسي والحضاري، منشورات دامعة دمشق، دمشق، 1996م. |
|
- |
العسكري، مرتضى: |
|
111. |
معالم المدرستين، مؤسسة النعمان، بيروت، 1991م. |
|
- |
العش، يوسف: |
|
112. |
الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان، دار الفك، ط5، دمشق، 1998م. |
|
- |
عطوي، رفيق خليل: |
|
113. |
صورة المرأة في شعر الغزل الأموي، دار العلم للملايين، بيروت، 1986م. |
|
- |
العلايلي، عبد الله: |
|
114. |
تاريخ الحسين نقد وتحليل، دار الجديد، د.م، 1994م. |
|
- |
العلوي، محمّد بن عقيل بن عبد الله: |
|
115. |
النصائح الكافية لمَن تولّى معاوية، دار الثقافة، قم، 1412هـ. |
|
- |
علي، موسى محمد: |
|
116. |
عقيلة الطهر والكرم السيّدة زينبI، مصر، د.ت. |
|
- |
عمارة، محمد: |
|
117. |
عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، المؤسسة العربية الدراسات، ط2، بيروت، 1979م. |
|
- |
عمر، أحمد مختار عبد الحميد: |
|
118. |
معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، د.م، 2008م. |
|
- |
عواضة، رضا ديب: |
|
119. |
المرأة في شعر (عمر بن أبي ربيعة ـ عمر بن أبي ريشة ـ نزار القباني)، شركة رشاد برس، بيروت، 1999م. |
|
- |
العوفي، أحمد محمد: |
|
120. |
أدب السياسة في العصر الأموي، دار النهضة، ط4، مصر، 1974م. |
|
(غ) |
|
|
- |
غربال، محمّد شفيق: |
|
121. |
الموسوعة العربية الميسّرة، دار النهضة لبنان، بيروت، 1980م. |
|
- |
ابن غيهب، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد: |
|
122. |
طبقات النسابين، دار الرشد، الرياض، 1987م. |
|
(ف) |
|
|
- |
الفاخوري، حنا: |
|
123. |
تاريخ الأدب العربي، دار اليوسف، بيروت، د.ت. |
|
- |
الفاضل الدربندي، آغا بن عابد الشيرواني(ت1285هـ/1868م): |
|
124. |
إكسير العبادات في أسرار الشهادات (المقتل الملم بمأساة الحسين^)، تح: محمّد جمعة بادي وعباس ملا عطية الجمري، شركة المصطفى للخدمات الثقافية، د.م، 1999م. |
|
- |
الفتلاوي، علي: |
|
125. |
المرأة في حياة الإمام الحسين^، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، كربلاء، د.ت. |
|
- |
الفراجي، عدنان علي: |
|
126. |
حركات المعارضة للخلافة الأموية 96 -105هـ / 714 – 723م، المكتبة العالية، بغداد، 1990م. |
|
- |
فروخ، عمر: |
|
127. |
تاريخ الآداب العربي، دار العلم للملايين، بيروت، 2006م. |
|
- |
فضل الله، مريم نور الدين: |
|
128. |
المرأة في ظل الإسلام، دار الزهراء، ، بيروت، د.ت. |
|
- |
الفكيكي، توفيق: |
|
129. |
سكينة بنت الحسين، مطبعة التعارف، ط2، بغداد، 1950م. |
|
- |
فواز، زينب بنت علي بن الحسين: |
|
130. |
الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 1312هـ.
|
|
(ق) |
|
|
- |
القرشي، باقر شريف: |
|
131. |
حياة الإمام الحسين بن علي÷ (دراسة وتحليل)، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1974م. |
|
132. |
حياة الإمام المهدي× دراسة وتحليل، مطبعة الأمين، د.م، 1996م. |
|
133. |
النظام التربوي في الإسلام دراسة مقارنة، دار التعارف، سوريا، 1988م. |
|
- |
القرشي، عباس بن محمّد بن مسعود(ت1299هـ/1882م): |
|
134. |
حماسة القرشي، تح: خير الدين محمود قبلاوي، وزارة الثقافة، دمشق، 1995م. |
|
- |
القزويني، محمّد كاظم: |
|
135. |
زينب الكبرى من المهد إلى اللحد، مؤسسة أم أبيها، بغداد، 2013م. |
|
- |
القمي، عباس(ت1395هـ/1975م): |
|
136. |
الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1417هـ. |
|
137. |
نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم، دار المرتضى، بيروت، 2008م. |
|
- |
القندوزي، سليمان بن إبراهيم(ت4294هـ/1877م): |
|
138. |
ينابيع المودة لذوي القربى، تح: علي جمال أشرف الحسيني، دار الأسوة، د.م، 1416هـ. |
|
(ك) |
|
|
- |
كحالة، عمر رضا: |
|
139. |
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، المطبعة الهاشمية، ط2، دمشق، 1958م.
|
|
- |
الكعبي، عبد الزهراء: |
|
140. |
مقتل الإمام الحسين× ومسير السبايا، صحّحه: محمود الشريفي، د.م، 1418هـ. |
|
- |
أبو كف، أحمد: |
|
141. |
آل بيت النبي| في مصر، دار المعارف، د.م، د.ت. |
|
- |
الكمونة، عبد الرزاق: |
|
142. |
مشاهد العترة الطاهرة وأعيان الصحابة والتابعين، النجف، 1968م. |
|
- |
الگلپايگاني، لطف الله الصافي: |
|
143. |
لمحات في الكتاب والحديث والمذاهب، مؤسسة البعثة، طهران، د.ت. |
|
(ل) |
|
|
- |
اللطيفي، محمود، وسيد رضا جعفري ومحمود الشريفي ومحمود أحمديان: |
|
144. |
موسوعة شهادة المعصومين^، انتشارات نور السجاد، قم، 1381هـ. |
|
(م) |
|
|
- |
المازندراني، محمّد مهدي: |
|
145. |
شجرة طوبى، منشورات المكتبة الحيدرية، ط5، النجف الأشرف، 1385هـ |
|
146. |
معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين÷، مؤسسة البلاغ، بيروت، 2011م. |
|
- |
ماهر، سعاد، وتوفيق أبو علم والشيخ عبد الحفيظ فرغلي وأحمد أبو كف وحنفي المحلاوى وعلي أحمد شلبي ومأمون غريب: |
|
147. |
أهل البيت في مصر، تقديم: سيد هادي خسرو شاهي، دار الهدف، القاهرة، 2001م. |
|
- |
مبارك، علي: |
|
148. |
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، دار الكتب، د.م، 1969م. |
|
- |
محمد، سراج الدين: |
|
149. |
الحكمة في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، د.ت. |
|
- |
محمد، سعاد ماهر: |
|
150. |
مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، إشراف: محمّد توفيق عويضة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مصر، د.ت. |
|
- |
محمد، نبيلة حسن: |
|
151. |
في تاريخ الدولة العربية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1993م. |
|
- |
المحمودي، محمّد باقر: |
|
152. |
نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 1965م. |
|
- |
المرعشي، نور الله الحسيني: |
|
153. |
شرح إحقاق الحقّ وازهاق الباطل، تعليق: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، منشورات آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم، د.ت. |
|
- |
مطهري، مرتضى: |
|
154. |
مسألة الحجاب، الدار الإسلامية، ط4، بيروت، 2008م. |
|
- |
المعاضيدي، عبد القادر: |
|
155. |
واسط في العصر الأموي 81هـ -132هـ، 700م – 749م، دار الحرية، بغداد، 1976م. |
|
- |
مغنية، محمّد جواد: |
|
156. |
الحسين وبطلة كربلاء، النجف الأشرف، د.ت. |
|
- |
المقرّم، عبد الرزاق الموسوي: |
|
157. |
السيّدة سكينة ابنة الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين÷، انتشارات الشريف الرضي، قم، 1413هـ. |
|
158. |
العبّاس×، تح:محمد الحسون، د.م، 2000م. |
|
159. |
مقتل الحسين× منشورات الفجر، بيروت، 2008م. |
|
- |
ملكي، رقية رستم بور: |
|
160. |
رثاء أهل البيت^ في شعر العصر الأموي، دار الهادي، د.م، 2000م. |
|
- |
الموسوي، جبار السيد موسى: |
|
161. |
الإمام الحسين×، مكتبة الأصدقاء، بغداد، 2011م. |
|
- |
الميانجي، علي الأحمدي: |
|
162. |
مكاتيب الرسول|، دار الحديث، طهران، 1419هـ. |
|
- |
الميلاني، علي: |
|
163. |
خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، مؤسسة البعثة، قم، 1404هـ. |
|
(هـ) |
|
|
- |
هارون، عبد السلام محمّد: |
|
164. |
نوادر المخطوطات، مكتبة مصطفى الحلبي، ط2، مصر، 1973م. |
|
- |
الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى: |
|
165. |
جواهر الأدب في أدبيّات وإنشاء لغة العرب، تح: لجنة من الجامعيين، مؤسسة المعارف، بيروت، د.ت. |
|
- |
الهاشمي، عبد المنعم: |
|
166. |
السيّدة سكينة رضي الله عنها، دار ومكتبة الهلال، بيروت، 2003م. |
|
(و) |
|
|
- |
الواحدي، محمّد رضا: |
|
167. |
السيّدة المجهولة لمحات من حياة السيّدة سكينة بنت أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب والسيّدة فاطمة الزهراء^، تعريب وإضافات: سيد رضي سيد أحمد الواحي، وزارة الإعلام، داريا، 2009م. |
|
- |
وجدي، محمّد فريد: |
|
168. |
دائرة معارف القرن العشرين، دار المعرفة، ط3، بيروت، 1971م. |
|
- |
الورداني، صالح: |
|
169. |
السيف والسياسة صراع بين الإسلام النبوي والإسلام الأموي، دار جسام، القاهرة، 1996م. |
|
(ي) |
|
|
- |
يعقوب، أحمد حسين: |
|
170. |
كربلاء الثورة والمأساة، مؤسسة الغدير، بيروت، 1997م. |
|
ثالثا: المراجع المترجمة |
|
|
_ |
بروكلمان، كارل: |
|
171. |
إمبراطورية العرب، تعريب وتعليق: خيري حماد، دار الكتاب العربي، بيروت، 1966م. |
|
- |
الخلخالي، علي الرباني: |
|
172. |
السيّدة رقية بنت الإمام الحسين÷، ترجم: جاسم الأديب، مؤسسة العروة الوثقى، قم، 2009م. |
|
- |
خودابخش: |
|
173. |
الحضارة الإسلامية، ترجمة وتعليق: علي حسن الخربوطلي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1960م. |
|
- |
سزكين، فؤاد: |
|
174. |
تاريخ التراث العربي، نقلة إلى العربية: محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل، الهيئة المصرية العامّة للكتاب، القاهرة، 1977م. |
|
- |
علي، سيد أمير: |
|
175. |
مختصر تاريخ العرب، نقله إلى العربية: عفيف البعلبكي، دار العلم للملايين، ط2، بيروت، 1967م. |
|
- |
فلهاوزن، يوليوس: |
|
176. |
تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية، تح: محمّد عبد الهادي وحسين مؤنس، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، 1986م. |
|
177. |
الخوارج والشيعة (المعارضة السياسية الدينية)، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، دار الجليل، ط5، القاهرة، 1998م. |
|
- |
مجموعة من العلماء المستشرقين: |
|
178. |
الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب، نقلة إلى العربية: نور الدين آل علي، راجعه: وديع فلسطين، دار الكتاب العربي، لبنان، 2007م. |
|
رابعاً: المجلات والدوريات |
|
|
- |
أحمد، عربية قاسم: |
|
179. |
من حركات المعارضة في العصر الأموي، بحث منشور في مجلة الأستاذ، العدد: 193، سنة: 2011م. |
|
- |
البسيوني، حسن: |
|
180. |
سكينة بنت الحسين بين الناس ومع الله، بحث منشور في مجلة الأزهر، ج 8، سنة: 1975م. |
|
- |
البنأ، حسن: |
|
181. |
المرأة المسلمة، بحث منشور في مجلة المنار، عدد: 35، سنة: 1359هـ. |
|
- |
البيومي، محمّد رجب: |
|
182. |
حول سكينة بنت الحسين، بحث منشور في مجلة الأزهر، مج 26، القاهرة، 1955م. |
|
- |
الحساني، محمّد رضا: |
|
183. |
الحسين بن علي، بحث منشور في مجلة القادسية، النجف الأشرف، العدد الخامس، السنة الرابعة، 1366هـ. |
|
- |
حسين، وسن إبراهيم: |
|
184. |
بيت مال المسلمين منذ التأسيس وحتى العصر العباسي (1 – 232هـ)/(622 -846م)، بحث منشور مجلة الأستاذ، عدد: 62، سنة: 2007 م. |
|
- |
الديوه جي، سعيد: |
|
185. |
السيّدة سكينة بنت الحسين، بحث منشور في مجلة الرسالة العدد: 496، القاهرة، 1943م. |
|
- |
السبعاوي، طه عبد الله محمّد: |
|
186. |
الحديث الضعيف ومدى الاحتجاج به في الفكر الإسلامي، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد: 25، بغداد، 2010م. |
|
- |
ضميرية، عثمان جمعة: |
|
187. |
عمل المرأة والاختلاط وأثره في انتشار الطلاق، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية، عدد: 77، سنة: 1426هـ /1427هـ. |
|
- |
عبد الرزق، زياد طارق: |
|
188. |
أثر وسائل الإعلام في السياسة، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، عدد: 23، سنة: 2009 م. |
|
- |
فضل الله، مريم نور الدين: |
|
189. |
حفيدة الزهراء سكينة.. والشبهات، بحث منشور في مجلة العرفان، عدد: 10، بيروت، سنة: 1983م. |
|
خامسا: الرسائل والأطاريح الجامعية |
|
|
- |
جاسم، مجبل عزيز: |
|
190. |
مراثِي الإمام الحسين× في العصر الأموي (دراسة فنية)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الكوفة، 2005م. |
|
- |
العاني، إسراء حسن فاضل: |
|
191. |
دور المرأة السياسي حتى نهاية العصر الأموي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، 1999م. |
|
- |
العبودي، هناء سعدون جبار: |
|
192. |
السيّدة زينب‘، ودورها في أحداث عصرها، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الكوفة، كلية الآداب، 2006م. |
|
- |
الناصري، عماد تالي مهدي: |
|
193. |
أنصار الإمام الحسين^ في واقعة الطف ـ دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، كلية التربية، 2009م. |
[1] البقرة: آية31.
[2] الفيض الكاشاني، محمّد، المحجّة البيضاء في تهذيب الإحياء: ج1، ص 111.
[3] المجادلة: آية11.
[4] البقرة: آية129.
[5] آل عمران: آية164.
[6]][6] الكفعمي، إبراهيم، المصباح: ص280.
[7] البقرة: آية253.
[8] الشعراء: آية 227.
[9]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمّد (ت356هـ/966م)، مقاتل الطالبيين، تح: أحمد صقر، دار المعرفة، (بيروت ـ د.ت): ص94؛ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن
الحسين (ت571هـ/1175م)، تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها، وتسمية مَن حلَّها من الأماثل،
أو اجتاز بنو حيها من وارديها وأهلها، تح: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، (د.م ـ 1995): ج69، ص204؛ السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت581هـ/1185م)، الروض
الأنف في شرح السيرة النبوية، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ 1412هـ): ج2، ص422؛ ابن الجوزي، أبو الفرج عبد
الرحمن بن علي (ت 597هـ/1200م)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تح: محمّد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية، (بيروت ـ1992م): ج7، ص175؛ السبط بن الجوزي، أبو المظفر يوسف شمس الدين (ت654هـ/ 1256م)، تذكرة
الخواص المعروف بتذكرة خواص الأُمّة في خصائص الأئمة، تح: عامر النجار، مكتبة الثقافة الدينية، (د.م ـ 2008م): ص565؛ ابن خلكان، أبو العبّاس شمس الدين أحمد، (681هـ/1282م)، وفيات الأعيان
وأنباء الزمان، تح: إحسان عباس، دار الثقافة، (بيروت ـ
د.ت): ج2، ص369؛ الذهبي، شمس الدين أبو عبد
الله بن أحمد (ت748هـ/1347م)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تح: عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب
العربي، (بيروت ـ 1987م): ج7، ص371؛ اليافعي، عبد الله بن أسعد بن علي (ت 768هـ/1366م)، مرآة الجنان وعبرة
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1997م): ج1، ص197؛ ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمّد (ت852هـ/1448م)،
نزهة الألباب في الألقاب، تح: عبد العزيز محمّد صالح السريري، مكتبة الرشد، (الرياض ـ 1989م): ج1، ص370؛ ابن تغري بردي، أبو المحاسن
يوسف بن عبد الله (ت874هـ/1469م)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، دار الكتب،
(مصر ـ د.ت): ج1، ص276؛ ابن عماد الحنبلي، عبد الحي
بن أحمد بن محمّد (ت1089هـ/1678م)، شذرات ذهب في أخبار من ذهب، تح: محمود الأرناؤوط، خرّج حواشيه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير،
(بيروت ـ 1986م): ج 2، ص82؛ المجلسي، محمّد باقر بن محمّد
تقي (ت1111هـ/1699م)،
[10]) محمّد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي، نسابة راوية، عالم بالتفسير والأخبار، من أهل الكوفة؛ تُوفي سنة ستة وأربعين ومائة؛ يُنظر: الذهبي، شمس الدين، أبو عبد الله بن أحمد (ت748هـ/1347م)، سير أعلام النبلاء، تح: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط3، (بيروت ـ 1985م): ج6، ص248ـ249.
[11]) عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، من أهل المدينة أمُّه فاطمة بنت الحسين، كان له منزلة عند عمر بن عبد العزيز، حُبس في عهد المنصور من أجل ابنيه محمّد وإبراهيم، فنُقل إلى الكوفة، فمات سجيناً هناك، سنة خمس وأربعين ومائة؛ يُنظر: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت463هـ/1072م)، تاريخ مدينة السلام وأخبار محدِّثيها وذكر قطانها العلماء من غير أهلها ووارديها، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، (بيروت ـ 2002م): ج11، ص90؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج27، ص364.
[12]) ابن النديم، أبو الفرج محمّد بن إسحاق بن محمّد (ت438هـ/1046م)، الفهرست، تح: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، ط2، (بيروت ـ 1997م): ص124.
[13]) التصحيف: تغيير اللفظ حتّى يتغيّر المعنى المراد من الموضع؛ أي أن يقرأ الشيء على خلاف ما أراده كاتبه، ولو على غير ما اطّلعوا عليه؛ يُنظر: أبو جيب، سعدى، القاموس الفقهي، دار الفكر، ط2، (دمشق ـ 1988م): ص208.
[14]) يُنظر: محمّد علي السيد يحيى، عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة، مؤسّسة السبطين÷ العالمية، ط2، (قم ـ1424هـ): هامش ص43.
[15]) عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة: ص46.
[16]) المدائني: جماعة منهم شبابة بن سوار المدائني، وابن أخيه سلام بن سلمان المدائني، وآخرون؛ يُنظر: الحافظ المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف (ت742هـ/1341م)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، (بيروت ـ 1980م): ج35، ص21.
[17]) يُنظر: الأصفهاني، علي بن الحسين بن محمّد، (356هـ/966م)، الأغاني، تح: سمير جابر، دار الفكر، ط2، (بيروت ـ د.ت): ج16، ص146.
[18]) تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص204.
[19]) يُنظر: محسن (ت1371هـ/1951م)، أعيان الشيعة، تح: حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، (بيروت ـ د.ت): ج3، ص491.
[20]) علي الرباني، السيّدة رقية بنت الإمام الحسين÷، ترجمة: جاسم الاديب، مؤسسة العروة الوثقى، (قم ـ 2009م): ص150.
[21]) يُنظر: الزبيري، مصعب بن عبد الله بن مصعب (ت236هـ/850م)، نسب قريش، تح: ليفي بروفنسال، دار المعارف، ط3، (القاهرة ـ د.ت): ص58ـ59؛ أبو نصر البخاري، سهل بن عبد الله (كان حي 341هـ/952م)، سرّ السلسلة العلوية، علّق عليه: سيد محمّد صادق بحر العلوم، انتشارات الشريف الرضي، (النجف ـ 1962م): ص30؛ المفيد، ابن عبد الله، محمّد بن محمّد (ت413هـ/1022م)، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، تح: مؤسَّسة آل البيت^ لتحقيق التراث، دار المفيد، ط2 (بيروت ـ 1993م): ج2، ص135؛ الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن (ت548هـ/1153م)، تاج المواليد في مواليد الأئمة ووفياتهم، مكتبة آية الله العظمى المرعشي، (قم ـ د.ت): ص35؛ البري، محمّد بن أبي بكر بن عبد الله (ت 645هـ/1247م)، الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة، علّق عليه: محمّد التونجي، دار الرفاعي، (الرياض ـ1983م): ج2، ص223؛ العمري، علي بن محمّد بن علي (ت 709هـ/1309م)، المجدي في أنساب الطالبيين، تح: أحمد المهدوي الدامغاني، مكتبة اية الله العظمى المرعشي النجفي، (قم ـ 1409هـ): ص91؛ ابن عنبة، جمال الدين أحمد (ت 828هـ/1424م)، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، دار الأندلس، (النجف ـ د.ت): ص192.
[22]) يُنظر: أبو الحسن ظهير الدين علي (ت 565هـ/1169م) لباب الأنساب والألقاب والأعقاب، (د. م ـ د.ت): ص43.
[23]) يُنظر: السيد حسن، بنات المعصومين دراسة وتوثيق، مؤسسة البلاغ، (بيروت ـ 2012م): ص100.
[24]) يُنظر: عبد الرزاق، السيّدة سَكينة ابنة الإمام الشهيد أبي عبد الله الحسين×، انتشارات الشريف الرضي، (قم ـ 1413هـ): ص140.
[25]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص94؛ السهيلي، الروض الأنف: ج2، ص422؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج7، ص175؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص396؛ اليافعي، مرآة الجنان: ج1، ص197؛ بن عماد الحنبلي، شذرات الذهب: ج2، ص82؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص47؛ الحائري، تراجم أعلام النساء: ج2، ص200.
[26]) الأزهري، أبو منصور محمّد بن أحمد (ت370هـ/980م)، تهذيب اللغة، تح: محمّد عوض مرعب، دار إحياء التراث، (بيروت ـ 2001م): ج10، ص42.
[27]) يُنظر: الزبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق (ت 1205هـ/1790م)، تاج العروس من جواهر القاموس، تح: علي شيري، دار الفكر، (بيروت ـ 1994م): ج18، ص290.
[28]) يُنظر: ابن منظور، أبو الفضل محمّد بن مكرم (ت711هـ/1311م)، لسان العرب، دار صادر، ط3، (بيروت ـ 1414هـ): ج13، ص213.
[29]) يُنظر: ابن دريد، أبو بكر محمّد بن الحسن (ت321هـ/933م)، جمهرة اللغة، تح: رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، (بيروت ـ 1987م): ج2، ص856.
[30]) يُنظر: أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني (ت1094هـ/1628م)، الكليات معجم المصطلحات والفروق اللغوية، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسَّسة الرسالة، (بيروت ـ د.ت): ص494.
[31]) البقرة: آية 248.
[32]) التوبة: آية 26.
[33]) التوبة: آية 40.
[34]) الفتح: آية 4.
[35]) الفتح: آية 18.
[36]) الفتح: آية 26.
[37]) الفتح: آية 18.
[38]) محمّد بن محمّد صادق، شذرات من فلسفة تاريخ الحسين×، تح: أسعد الناصري، إصدارات مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد الشهيد محمّد الصدر(النجف ـ 1428هـ): ص145.
[39]) عائشة عبد الرحمن، سكينة بنت الحسين÷، دار الكتاب العربية، (بيروت ـ د.ت): ص26.
[40]) الطيالسي، أبو داود، سليمان بن داود (ت204هـ/819م)، مسند أبي داود الطيالسي، تح: محمّد عبد المحسن، دار هجر، (مصر ـ 1999م)، (رقم الحديث 2834): ج4، ص430؛ ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمّد (ت235هـ/849م)، المصنّف في الأحاديث والآثار، تح: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، (الرياض ـ 1409هـ)، (رقم الحديث 31676): ج6، ص308؛ ابن راهوية، أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم (ت238هـ/852م)، مسند إسحاق بن راهوية، تح: عبد الغفور بن عبد الحقّ البلوشي، مكتبة الإيمان، (المدينة المنورة ـ 1991م)، (رقم الحديث 184): ج1، ص227؛ ابن ماجة، أبو عبد الله محمّد بن زيد (ت273 هـ/886م)، سنن ابن ماجة، تح: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، (د. م ـ د.ت)، (رقم الحديث 4308): ج2، ص1440.
[41]) يُنظر: الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام (ت211هـ/826م)، المصنف، تح: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، ط2، (بيروت ـ 1403هـ): ج3، (رقم الحديث 5246): ص183؛ النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري (ت261هـ/874م)، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله|، تح: محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ د.ت)، (رقم الحديث 2278): ج4، ص1782.
[42]) ابن بطّال، أبو الحسن علي بن خلف
(ت449هـ/1057م)، شرح صحيح البخاري، تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشيد، ط2، (الرياض ـ2003م) (رقم الحديث 20): ج9، ص407؛ ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل
أحمد بن علي (ت852هـ/1448م)، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تعليق: عبد العزيز بن عبد الله، دار المعرفة،
ط2، (بيروت ـ1379هـ) (رقم الحديث 6565): ج11، ص436؛ المناوي
[43]) يُنظر: ابن سيدة، أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت458هـ/1065م)، المخصص، تح: خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ1996م): ج1، ص319.
[44]) يُنظر: عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، (د. م ـ 2008م): ج1، ص135.
[45]) يُنظر: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين× بن محمّد (ت502هـ/1108م)، المفردات في غريب القرآن، تح: صفوان عدنان الداودي، دار القلم ودار الشامية، (دمشق وبيروت ـ 1412هـ): ص96.
[46]) يُنظر: ابن نشوان، محمّد بن نشوان بن سعيد (ت573هـ/1177م)، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تح: حسين عبد الله العمري ومظهر بن علي ويوسف محمّد عبد الله، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، (بيروت ودمشق ـ 1999م): ج1، ص345.
[47]) الأحزاب: آية 33.
[48]) أمُّ سلمة: هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله، زوجة النبي محمد| يُقال لها خطيبة النساء، وفدت سنة 1 هـ، فبايعت الرسول|، روت عنه الكثير من الأحاديث، تُوفيت سنة 62هـ، يُنظر: ابن سعد، أبو عبد الله محمّد بن منيع (ت230هـ/844م)، الطبقات الكبرى، تح: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1990م): ج8، ص69؛ الزركلي، خير الدين بن محمود (ت1396هـ/1976م)، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، ط15، (د. م ـ2002م): ج1، ص306.
[49]) خميصة: هو كساء مربع مُعلَّم، كان الناس يلبسونها فيما مضى، وأكثر ما تكون سوداء؛ يُنظر: ابن دريد، جمهرة اللغة: ج1، ص65.
[50]) ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمّد (ت241هـ/855م)، فضائل الصحابة، تح: وصي الله محمّد عباس، مؤسسة الرسالة، (بيروت ـ 1983م)، (رقم الحديث 986): ج2، ص583.
[51]) يُنظر: أبو يعلي، أحمد بن علي بن المثنى (ت307هـ/919م)، مسند أبي يعلي، تح: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، (دمشق ـ 1984م)، (رقم الحديث 6888): ج2، ص313؛ الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمّد (ت321هـ/913م)، شرح مشكل الآثار، تح: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، (د. م ـ1415م)، (رقم الحديث767): ج2، ص241.
[52]) يُنظر: الحاكم النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمّد بن عبد الله بن محمّد (ت405هـ/ 1058م)، المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ1990م)، (رقم الحديث 3558): ج 2، ص451.
[53]) عائشة: بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة، أُّمُّها أمُّ رومان بنت عمير، تزوَّجها النبي| سنة 2هـ كانت ممّن نقم على عثمان في حياته، ثمّ غضبت له بعد مقتله، فكان لها في هودجها بواقعة الجمل موقفها المعروف، توفيت سنة 58هـ؛ يُنظر، ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص46؛ الزركلي، الاعلام: ج3، ص240.
[54]) مُرط: هو كساء من الصوف أو الخزّ كان يُؤتَزر بها؛ يُنظر: الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت393هـ/1002م)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطا، دار العلم للملايين، ط4، (بيروت ـ1987): ج3، ص1159.
[55]) ابن أبي شبية، المصنف، (رقم الحديث 32102): ج6، ص370؛ ابن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه، (رقم الحديث 271): ج3، ص687؛ ابن كرامة، شرف الإسلام بن سعيد المحسن (ت494هـ/1100م)، تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين، تح: السيد تحسين آل شبيب، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، (د. م ـ 1420هـ): ص136؛ الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير بن رستم (ت ق5هـ/ق 11م)، دلائل الإمامة، قسم الدراسات الإسلامية، (قم ـ 1413هـ): ص21.
[56]) أبو الحسن علي بن أحمد (ت468هـ/1075م ـ)، أسباب النزول القرآن، تح: عصام بن عبد المحسن، دار الإصلاح، ط2، (الدمام ـ 1992م): ص354.
[57]) القندوزي، سليمان بن إبراهيم، (1294هـ/1877م)، ينابيع المودة لذوي القربى، تح: علي جمال أشرف الحسيني، دار الأسوة، (د. م ـ1416هـ): ج3، ص282.
[58]) الخزار القمي، أبو القاسم، علي بن محمّد (ت400هـ/1009م)، كفاية الأثر في النصِّ على الأئمة الاثني عشر، تح: عبد اللطيف الحسيني، انتشارات بيدار، (قم ـ1401هـ): ص156.
[59]) تقي الدين أبو العبّاس، أحمد (ت728هـ/1327م)، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تح: رشاد سالم، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، (د. م ـ 1986م): ج4، ص22.
[60]) الشورى: آية 23.
[61]) الحسكاني، عبيد الله ابن أحمد (ت ق 5هـ/11م)، شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت^، تح: شيخ محمّد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، (د. م ـ 1411هـ): ج2، ص189؛ الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر (ت807هـ/1404م)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ1988): ج9، ص168؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (ت911هـ/1505م)، الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور، دار المعرفة، (جدّة ـ1365هـ): ج6، ص7.
[62]) الشورى: آية 23.
[63]) المتقي الهندي، علاء الدين علي (ت 975هـ/1567م)، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تح: بكري حياني صفوت السقا، مؤسَّسة الرسالة، ط5، (د. م ـ 1981م)، (رقم الحديث 4030): ج2، ص290.
[64]) آل عمران: آية 61.
[65]) المباهلة: هي اللعنة، مأخوذة من الإبهال، وهو الإهمال والتخلية، ومعنى المباهلة أن يجتمعوا إذا اختلفوا، فيقولوا: بهله الله على الظالم؛ يُنظر: الزمخشري، جار الله أبو القاسم، محمود بن عمرو (ت538هـ/1143م)، الفائق في غريب الحديث والأثر، تح: علي محمّد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، ط2، (لبنان ـ د.ت): ج1، ص140.
[66]) نجران: من مخاليف اليمن من ناحية مكّة؛ يُنظر: ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله الرومي (ت626هـ/1228م)، معجم البلدان، دار صادر، ط2، (بيروت ـ1995م): ج5، ص266.
[67]) يُنظر: بَحْرَق اليمني، محمّد بن عمر بن مبارك (ت930هـ/1523م)، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، تح: محمّد غسّان، دار المنهاج، (جدّة ـ 1419هـ): ص75.
[68]) الجزية: هي فريضة تُفرض على كلِّ يهودي أو نصراني، أبى أن يدخل الإسلام؛ حيث تقع الجزية على كلِّ حالمٍ ذكرٍ وانثى، وقدرها دينار وافٍ في كلِّ عام؛ يُنظر: ابن زنجويه، أحمد بن مخلد بن قتيبة (ت251هـ/865م)، الأموال، تح: شاكر ذيب فياض، مركز الملك فيصل، (السعودية ـ 1986م): ص125.
[69]) يُنظر: المعتزلي، القاضي عبد الجبار بن أحمد (ت415هـ/1024م)، تثبيت دلائل النبوّة، دار المصطفى، (القاهرة ـ د.ت): ج2، ص426.
[70]) يُنظر: الثعلبي، أحمد بن محمّد بن إبراهيم (ت427هـ/1035م)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تح: الإمام أبي محمّد بن عاشور، تدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ 2002م): ج3، ص85؛ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمّد (ت450هـ/1058م)، النكت والعيون، تح: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ د.م): ص398؛ الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد (ت468هـ/1075م)، الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تعليق وتح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، تقديم: عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1994م): ج1، ص444؛ البغوي، أبو محمّد الحسين بن مسعود (ت510هـ/1116م)، معالم التنزيل في تفسير القرآن، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ1420هـ): ج1، ص450؛ الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ د.ت): ج1، ص396؛ ابن عطية الأندلسي، أبو محمّد عبد الحق ابن غالب (ت542هـ/1147م)، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد السلام عبد الشافي محمّد، دار الكتب العلمية، (لبنان ـ 1993م): ج1، ص461؛ البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر (ت685هـ/1286م)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمّد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ 1418هـ): ج2، ص20.
[71]) ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمّد (ت235هـ/849م)، مسند ابن أبي شيبة، تح: عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن مزيد المزيدي، دار الوطن، (الرياض ـ 1997م)، (رقم الحديث 135): ج1، ص108؛ أبو نصر الكشي، أبو محمّد، عبد الحميد بن حميد (ت249هـ/863م)، المنتخب من مسند عبد الحميد، تح: صبحي البدري السامرائي ومحمود محمّد الصعيدي، مكتبة السنة، (القاهرة ـ 1988م)، (رقم الحديث 265)، ص114؛ ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمر (ت287هـ/900م)، السنة، تح: محمّد ناصرالدين الألباني، المكتب الإسلامي، (بيروت ـ 1400هـ)، (رقم الحديث 1551): ج1، ص643؛ النسائي، أبو عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب (ت303هـ/915م) السنن الكبرى، تح: حسن عبد المنعم الشلبي، مؤسَّسة الرسالة، (بيروت ـ 2001م)، (رقم الحديث 8410): ج7، ص437.
[72]) الترمذي، محمّد بن عيسى بن سورة (ت279هـ/892م)، الجامع الكبيرـ سنن الترمذي، تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، (بيروت ـ1988م) (رقم الحديث 3786): ج6، ص131؛ القاضي عياض، أبو الفضل عياض بن موسى (ت544هـ/1149م)، الشفا بتعريف حقوق المصطفى مذيَّل بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، حاشية: أحمد بن محمّد بن محمّد، دار الفكر، (د. م ـ 1988م): ج2، ص47.
[73]) المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي (ت845هـ/1441م)، إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تح: محمّد عبد الحميد النميسي، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1999م): ج5، ص378؛ الشامي، محمّد بن يوسف الصالحي(ت942هـ/1535م)، سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وإعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، تح: عادل أحمد وعلي محمّد معوض، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1993م): ج12، ص232.
[74]) ابن حنبل، فضائل الصحابة، (رقم الحديث 1402) ج2، ص785؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، (رقم الحديث 3311): ج2، ص373؛ الحرضي، يحيى ابن أبي بكر بن محمّد (ت893هـ/1487م)، بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، دار صادر، (بيروت ـ د.ت): ج2، ص401؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت911هـ/1505م)، الخصائص الكبرى، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ د.ت): ج2، ص466.
[75]) ابن حجر الهيثمي، أبو العبّاس، أحمد بن محمّد (ت974هـ/1566م)، الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة، تح: عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكمال محمّد الخراط، مؤسَّسة الرسالة، (لبنان ـ 1997م): ج2، ص496.
[76]) ابن حنبل، عبد الله أحمد بن محمّد (ت241هـ/1566م)، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسَّسة الرسالة، (قم ـ 2001م)، (رقم الحديث 19265): ج32، ص11؛ الدارمي، أبو عبد الله بن عبد الرحمن (ت255هـ/868م)، سنن الدارمي، تح: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، (المملكة العربية السعودية ـ 2000م)، (رقم الحديث 3359): ج4، ص2090؛ اللاكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن (ت418هـ/1027م)، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، تح: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار الطيبة، ط8، (السعودية ـ 2003م): ج1، ص87؛ البيهقي، أحمد بن الحسين× بن علي (ت458هـ/1065م)، الإعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، تح: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة، (بيروت ـ 1401هـ): ص325.
[77]) ابن حنبل، فضائل الصحابة، (رقم الحديث 1952): ج2، ص986؛ الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب (ت360هـ/970م)، المعجم الكبير، تح: حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة العلوم والحكم، ط2، (الموصل ـ 1983م)، (رقم الحديث 4639): ج3، ص46؛ الكلاباذي، أبو بكر محمّد بن أبي إسحاق (ت380هـ/990م)، بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار، تح: محمّد حسن محمّد وأحمد مزيد المزيدي، دار الكتب العلمية، ط2، (بيروت ـ1999م): ص20؛ البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي (ت458هـ/1065م)، الآداب، تح: أبو عبد الله السعيد المندوه، مؤسَّسة الكتب الثقافية، (بيروت ـ 1988)، (رقم الحديث 852): ص344.
[78]) الديلمي، شيروبه بن شهردار (ت509هـ/1115م)، الفردوس المأثور الخطاب، تح: السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1986م): ج2، ص142.
[79]) الإمام الصادق: هو أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب^، هو شيخ من بني هاشم قريشي هاشمي علوي مدني، أحد الأعلام، أُمُّه هي أُمُّ فروة بنت القاسم بن محمّد ابن أبي بكر التميمي، وُلد سنة 80هـ، وكان من أجلّة علماء المدينة، روى الكثير من الأحاديث، وهو من ثقات الناس، فعن الحسن بن زيادة قال: ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن محمّد، اختلفت الروايات حول تاريخ وفاته قيل: 148هـ، وقيل 168هـ. يُنظر: ابن المستوفي، شرف الدين بن مبارك ابن أحمد (ت637هـ/1239م)، تاريخ إربل، تح: سامي بن سيد خماس الصقار، دار الرشيد للنشر، (العراق ـ 1980م): ج2، ص633؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج6، ص255؛ بدر الدين العيني، أبو محمّد محمود بن أحمد (ت855هـ/1451م)، مغاني الأخبار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، تح: محمّد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ2006م) ج1، ص153؛ الخزرجي، أحمد ابن عبد الله بن أبي الخير (ت بعد 923هـ/1516م)، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، دار البشائر، ط5، (حلب وبيروت ـ 1416هـ): ص63.
[80]) البرقي، أبو جعفر أحمد بن محمّد (ت274هـ/887م)، المحاسن، تح: جلال الدين الحسيني، دار الكتب الإسلامية، (د. ت ـ د. م): ج1، ص150؛ الري شهري، محمّد، ميزان الحكمة، دار الحديث، (د. ت ـ د. م): ج3، ص1799.
[81]) القاضي النعمان، أبو حنيفة النعمان بن محمّد المغربي (ت363هـ/973م)، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار×، تح: محمّد حسيني الجلالي، مؤسَّسة النشر الإسلامية، (قم ـ د.ت): ج1، ص162.
[82]) ابن حنبل، فضائل الصحابة، (رقم الحديث 1070): ج2، ص626؛ ابن حمزة الحسيني، إبراهيم بن محمّد بن محمّد (ت1120هـ/1708م)، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف، تح: سيف الدين الكاتب، دار الكتاب العربي، (بيروت ـ د.ت) (رقم الحديث 1316): ج2، ص45؛ الشوكاني، محمّد بن علي بن محمّد (ت1250هـ/1834م)، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تح: عصام الدين الصبايطي، دار الحديث، (مصر ـ د.ت): ج6، ص38.
[83]) يُنظر: بَحْشَل، أسلم بن سهل بن أسلم بن حبيب (ت292هـ/905م)، تاريخ واسط، تح: كوركيس عواد، عالم الكتب، (بيروت ـ 1406هـ): ص99.
[84]) يُنظر: أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد (ت430هـ/1038م)، معرفة الصحابة، تح: عادل يوسف، دار الوطن، (الرياض ـ 1998م): ج4، ص1968.
[85]) يُنظر: خديجة الكبرى: أمُّ المؤمنين خديجة بنت خويلد، بنت أسد بن عبد العزى، من قريش تزوَّجت الرسول محمداً | وهي أسنُّ منه بخمس عشرة سنة، فولدت له القاسم وعبد الله ورقية وأُمَّ كلثوم وفاطمة، توفيت في مكّة، يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص11 ـ 12؛ الزركلي، الأعلام: ج2، ص302.
[86]) يُنظر: الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق، تح: محمّد صادق آيدن الحامدي، دار القادري، (دمشق ـ 1417هـ): ج3، ص1622.
[87]) يُنظر: الخوارزمي، الموَفَّق بن أحمد بن محمّد المكي (ت568هـ/1172م) المناقب، تح: مالك المحمودي، مؤسَّسة النشر الإسلامي، ط2، (قم ـ1411هـ). ص40.
[88]) يُنظر: الآجري، أبو بكر محمّد بن الحسن (ت360هـ/970م)، الشريعة، تح: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، (الرياض ـ 1999م): ج45، ص1756.
[89]) المتفق والمفترق: ج3، ص1622.
[90]) ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير (ت833هـ/1429م)، مناقب الأسد الغالب، ممزِّق الكتائب ومظهر العجائب، ليث بن غالب أمير المؤمنين، أبو الحسن علي بن أبي طالبE، تح: طارق الطنطاوي، مكتبة القرآن، (د. م ـ 1994م): ص23.
[91]) ابن المغازلي، علي بن محمّد بن محمّد بن الطيب (ت483هـ/1090م)، مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبE، دار الآثار، (صنعاء ـ 2003م): ص283.
[92]) موضع بينها وبين المدينة مشي ثلاثة أيام، فيه مسجد الرسول|؛ يُنظر: البكري، أبو عبيد عبد الله ابن عبد العزيز (ت487هـ/1094م)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عالم الكتب، ط3، (بيروت ـ1403هـ): ج2، ص521.
[93]) الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي، (رقم الحديث 2563): ج4، ص187؛ ابن حنبل، فضائل الصحابة، (رقم الحديث 1030): ج2، ص602؛ الروياني، أبو بكر محمّد بن هارون (ت307هـ/919م)، مسند الروياني، تح: أيمن علي يماني، مؤسَّسة قرطبة، (القاهرة ـ1416هـ) (رقم الحديث 1172): ج2، ص261.
[94]) محبُّ الدين الطبري، أحمد بن عبد الله بن محمّد (ت694هـ/1294م)، الرياض النضرة في مناقب العشرة، دار الكتب العلمية، (د. م ـ د.ت): ج3، ص138.
[95]) يُنظر: ابن حبيب، محمّد بن حبيب بن أمية بن عمرو (ت245هـ/859م)، المحبر، تح: إِليزة ليختن شتيتر، دار الآفاق الجديدة، (بيروت ـ د.ت): ص125ـ ص126.
[96]) ابن حنبل، فضائل الصحابة، (رقم الحديث 954): ص566؛ البخاري، محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت256هـ/869م)، تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، إعداد: محمّد عبد الكريم، مكتبة الرشد، (الرياض ـ 1999م)، (رقم الحديث 90): ص396.
[97]) غدير خُمٍّ: هو موضع يُقال له خرَّار، وخُمٌّ: اسم بئر احتفرها عبد شمس بالبطحاء بعد بئره الجحول، يُنظر: البكري، معجم ما استعجم: ج2، ص510.
[98]) الترمذي، الجامع الكبير: ج6، ص74؛ النسائي، السنن الكبرى، (رقم الحديث 8089): ج7، ص309؛ ابن خزيمة، أبو بكر محمّد بن إسحاق (ت311هـ/923م)، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عزَّ وجلَّ، تح: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، ط5، مكتبة الرشد، (الرياض ـ 1994م): ج1، ص69.
[99]) يُنظر: الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله بن أحمد (ت748هـ/1347م)، المقتنى في سرد الكنى، تح: محمّد صالح عبد العزيز، مجلس العلمي، (المدينة المنورة ـ 1408هـ): ج2، ص167.
[100]) يُنظر: ابن حنبل، فضل الصحابة، (رقم الحديث 1331): ج2، ص757؛ الترمذي، الجامع الكبير، (رقم الحديث 3781): ج6، ص127؛ ابن الأعرابي، أحمد بن محمّد بن زياد (ت340هـ/952م)، المعجم لابن الأعرابي، تح: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد، دار ابن الجوزي، (السعودية ـ 1997م): ج1، ص218؛ البيهقي، الإعتقاد والهداية: ص328.
[101]) الاحزاب: آية 33.
[102]) آل عمران: آية 61.
[103]) الشورى: آية 23.
[104]) ابن أبي شيبة، المصنف، (رقم الحديث 32269): ج6، ص388؛ ابن أبي عاصم، أبو بكر أحمد بن عمرو (ت287هـ/900م)، الآحاد والمثاني، تح: باسم فيصل أحمد الجوايرة، دار الراية، (الرياض ـ 1991م)، (رقم الحديث 2956): ج5، ص362؛ أبو طاهر المخلص، محمّد بن عبد الرحمن (ت393هـ/1002م)، المخلصيات، تح: نبيل سعد الدين جرار، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، (قطرـ 2008م)، (رقم الحيث 1304): ج2، ص174.
[105]) الأصفهاني، أبو محمّد، عبد الله بن محمّد (ت369هـ/979م)، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها، تح: عبد الغفور عبد الحق، مؤسَّسة الرسالة، ط2، (بيروت ـ 1992م): ج3، ص132.
[106]) الحاكم النيسابوري، محمّد أبو عبد الله محمّد (ت405هـ/1015م)، فضائل فاطمة الزهراء، تح: علي رضا بن عبد الله بن علي، دار الفرقان، (القاهرة ـ1429هـ)، (رقم الحديث 50): ص58.
[107]) ابن شهر آشوب، شير الدين أبو عبد الله (ت588هـ/1192م)، مناقب آل أبي طالب، تح: لجنة من أساتذة النجف الأشرف، (النجف ـ1956م): ج3، ص107.
[108]) يُنظر: ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي (ت852هـ/1448م)، تقريب التهذيب، تح: محمّد عوامة، دار الرشيد، (سوريا ـ 1986م): ص751.
[109]) يُنظر: الصفدي، صلاح الدين خليل بن آيبك (ت764هـ/1362م)، الوافي بالوفيات، تح: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، (بيروت ـ2000م): ج1، ص47.
[110]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج 16، ص150؛ البستاني، سليمان بن خطار بن سلوم، كتاب دائرة المعارف، مطبعة الأدبية، (بيروت ـ1887م): ج9، ص245؛ فواز، زينب بنت علي بن الحسين، الدر المنثور في طبقات ربات الخدور، المطبعة الكبرى الأميرية، (مصر: 1312هـ): ص245.
[111]) يُنظر: السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت771هـ/1369م)، طبقات الشافعية الكبرى، تح: محمود محمّد الطناحي وعبد الفتاح محمّد الحلو، دار هجر، ط2، (د. ت: 1413هـ): ج1، ص314.
[112]) يُنظر: الوافي بالوفيات: ج15، ص184.
[113]) إبراهيم بن عمر بن الحسن الرباط (ت885هـ/1480م)، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تح: عبد الرزاق غالب المهدي، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1995م): ج8، ص549.
[114]) يُنظر: القرشي، باقر شريف، النظام التربوي في الإسلام دراسة مقارنة، دار التعارف، (سوريا ـ 1988م): ص64 ـ 65.
[115]) حسن موسى، المرأة العظيمة، قراءة في حياة السيّدة زينب بنت علي÷، انتشارات العربي، (د. م: 2010م): ص23.
[116]) وُلد في شعبان سنة أربع للهجرة، وقيل: لخمس خلون من شعبان من نفس السنة، وهو من الفقهاء العاملين بالكتاب والسنة؛ يُنظر: ابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت630هـ/1232م)، أسد الغابة في معرفة الصحابة، تح: معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، (د. م ـ1994م): ج2، ص24؛ البري، محمّد ابن أبي بكر بن عبد الله (ت 645هـ/1247م)، الجوهرة في نسب الإمام علي وآله، تح: محمّد التونجي، مؤسَّسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ـ 1402هـ): ص38.
[117]) يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص280.
[118]) يُنظر: الديار بكري، حسين بن محمّد بن الحسن (ت966هـ/1558م)، تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس، (بيروت ـ د.ت): ج1، ص418.
[119]) الإنسان: آية 5ـ7.
[120]) يُنظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : ج10، ص99؛ الرازي، فخر الدين محمّد (ت606هـ/1209م)، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 2000م): ج1، ص215.
[121]) الحاكم النيسابوري، المستدرك، (رقم الحديث 4776): ج3، ص181.
[122]) هو ابن أبي طالب بن عبد المطّلب، أُمُّه أسماء بنت عميس، كان عبد الله صهر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب×، حيث كانت ابنته زينبB عنده، تُوفي سنة 80هـ، يُنظر: ابن فندمة، أبو الحسن ظهير الدين علي بن زيد (ت565هـ/1170م)، تاريخ بيهق، دار اقرأ، (دمشق ـ 1425هـ): ص171ـ 172؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج27، ص253.
[123]) النعماني، ابن أبي زينب محمّد بن إبراهيم (ت380هـ/990م)، كتاب الغيبة، تح: علي أكبر الغفاري، مكتبة الصدوق، (طهران ـ د.ت): ص95 ـ96.
[124]) الإمامة: هي ميراث النبي|، فيختار لها من يكون أشبه به خلقاً وعلماً وقراءة وصلاحاً ونسباً، وصاحبها يُسمَّى الإمام الأكبر، يقوم بالرئاسة العامة في الدين والدنيا، والخلافة عن النبي|؛ وسُمِّيت العظمى لتُميَّز عن الصغرى، وهي إمامة الصلاة؛ يُنظر: نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول (ت ق12هـ/18م)، دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون)، تعريب: حسن هاني فحص، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 2000م): ج1، ص128؛ عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، (د. م ـ د.ت): ج1، ص283.
[125]) الولاية هي من الولي، وهي ضدّ العدوِّ، يُقال: وليُّ اليتيم والقتيل مالك أمرهما، ومنه الولي هو والي البلد، وهي على نوعين: إمّا أن تكون عامة فهي الخلافة أو الإمامة العظمى، وإمّا أن تكون خاصَّة على ناحية كأن ينال أمر إقليم ونحوه؛ يُنظر: القونوي، قاسم بن عبد الله الحنفي (ت978هـ/1570م)، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، تح: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، (د. م ـ2004م): ص51.
إنَّ الولاية الكبرى والإمامة العظمى لا يمكن أن تُقلَّدا إلاّ بأذن الله ونصبه، وهو المنصب الإلهي، الذي يكون صاحبه والياً ومشرفاً على جميع أمور الدين والدنيا بعد النبي|، وهو مقام الخلافة التي يليها أئمة أهل البيت الاثنا عشر^، ففي قول لأمير المؤمنين×: (اللهمَّ بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إمام ، ظاهراً مشهوراً، أوخائفاً مغموراً؛ لئلاً تبطل حجج الله وبيناته)؛ يُنظر: الشريف الرضي، محمّد بن الحسين بن موسى (ت403هـ/1012م)، نهج البلاغة (مجموعة خطب الإمام علي×، تح: محمّد عبده، دار المعرفة، (بيروت ـ د.ت): ج4، ص37؛ الگلپايگاني، لطف الله الصافي، لمحات في الكتاب والحديث والمذاهب، مؤسَّسة البعثة، (طهران ـ د.ت): ص218.
[126]) يُنظر: خليفة بن خياط، أبو عمرو، خليفة الشيباني العصفري (ت240هـ/854م)، طبقات خليفة بن خياط، تح: سهيل زكار، دار الفكر، (د. م ـ 1993م): ص30؛ الدولابي، أبو بشر محمّد بن أحمد (ت310هـ/922م)، الذرية الطاهرة النبوية، تح: سعد المبارك الحسن، الدار السلفية، (الكويت ـ 1407هـ): ص97؛ ابن قنفذ، أبو العبّاس أحمد بن الحسن (ت810هـ/1407م)، الوفيات معجم زمني للصحابة والمحدثين والفقهاء والمؤلِّفين، تح: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، ط4، (بيروت ـ 1983م): ص74.
[127]) هو من بني آكل المرار، أُمُّه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث، اسمه حندج، وقيل: عدي، وقيل: مليكة ولُقِّب بذي القروح، وبالملك الضلِّيل، وبامرئ القيس، وطغى هذا اللقب على اسمه وعُرف به، أبوه كان قد طرده.. ولما عرف مقتل أبيه قال: ضيَّعني صغيراً، وحمّلني دمه كبيراً...، نشأ في نجد من أسرة توارثت الملك، ودانت لها قبائل العرب من ربيعه ومضر، ومضى يتردّد بين أمره، خاله المهلهل، يعتبر من فحول شعراء الجاهلية، والمقدَّم في الطبقة الأولى؛ يُنظر: الكندي، امرئ القيس بن حجر بن الحارث (ت80 ق هـ)، ديوان امرئ القيس، اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة، ط2، (بيروت ـ 2004م)، ترجمة امرئ القيس: ص9؛ ابن قتيبة الدينوري، أبو محمّد، عبد الله بن مسلم (ت276هـ/889م)، الشعر والشعراء، دار الحديث، (القاهرة ـ1423هـ): ج1، ص115؛ أبوالفضل الميداني، أحمد بن محمّد بن إبراهيم (ت518ه/1124م)، مجمع الأمثال، تح: محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، (بيروت ـ د.ت): ج2، ص417؛ الهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (ت1362هـ/1943م)، جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب، تح: لجنة من الجامعيين، مؤسَّسة المعارف، (بيروت ـ د.ت): ج2، ص30.
[128]) يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص346؛ الزبيدي، نسب قريش: ص59؛ الطبري، محمّد ابن جرير بن زيد (ت310هـ/922م)، المنتخب في كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعيين، دار التراث، ط2، (بيروت ـ 1387هـ): ج11، ص520.
[129]) فلج: هي مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة وقشير وكعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ تقع في وسط الصحراء، وهي ناحية كبيرة عُرفت بالتعصُّب، تبعد عن مكّة ثمانين ومائة فرسخ؛ يُنظر: ناصر خسرو، أبو معين الدين (ت481هـ/1088م)، سفرنامة، تح: يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، ط3، (بيروت ـ 1983م): ص139؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص271.
[130]) عوف بن خارجة: لم أعثر على ترجمته.
[131]) صهر: أهل بيت المرأة؛ يُنظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة: ج7، ص717.
[132]) يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص119؛ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت774هـ/1372م)، البداية والنهاية، تح: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، (بيروت ـ 1988م): ج8، ص229؛ ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي (ت852هـ/1448م) الإصابة في تمييز الصحابة تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، دار الكتب العلمية (بيروت ـ 1415هـ): ج1، ص355.
[133]) درعك الحطمية: هي التي تحطم السيوف، أي تكسرها، وقيل، هي العريضة الثقيلة؛ يُنظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج1، ص402.
[134] يُنظر: ابن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، ترتيب: الأمير علاء الدين، تعليق: شعيب الأرناؤوط، مؤسّسة الرسالة، (بيروت ـ 1988م): ج15، ص396؛ البيهقي، السنن الكبرى، تح: محمّد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، ط3، (بيروت ـ 2003م)، (رقم الحديث 21295): ج10، ص454.
[135]) يُنظر: السيّدة سكينة: ص134.
[136]) يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج10، ص101.
[137]) علي بن مجاهد بن مسلم القاضي الكابلي، متروك، كان يضع الحديث، لقد صنّف كتاب المغازي، وكان يضع كلامه اسناداً، تُوفي بعد الثمانين؛ يُنظر: الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام: ج13، ص592؛ ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل احمد بن علي (ت852هـ/1448م)، تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة النظامية، (الهند ـ 1326هـ): ج7، ص378.
[138]) يُنظر: الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة السلام: ج13، ص592؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج1، ص134.
[139]) القضاعي، أبو عبد الله محمّد بن سلامة (ت454هـ/1062م)، مسند الشهاب القضاعي، تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، (بيروت ـ 1986م): ج1، ص370.
[140]) عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن جذيمة، قد أسلم قديماً، ثمّ افتُتِن وخرج من المدينة إلى مكّة مرتدّا، فاهدر رسول الله| دمه يوم الفتح، فجاء عثمان بن عفان إلى النبي| فاستأمن له فآمنه، وكان أخاه من الرضاعة، شهد فتح مصر واختطَّ بها، وكان صاحب الميمنة في حرب عمرو بن العاص في فتح مصر، ففي سنة 26هـ عزل عثمان عمرو بن العاص عن خراج مصر، واستعمل عليها أخاه عبد الله ثمّ سار عبد الله إلى افريقية، وفتحها بعد حصار طويل، وفي عام 27هـ غزا افريقية والأساور من ارض النوبة سنة 31هـ، وذات الصواري من أرض الروم عام 34؛ يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج7، ص344؛ ابن يونس، عبد الرحمن بن أحمد بن يونس (ت347هـ/958م)، تاريخ ابن يونس المصري، دار الكتب العلمة، (بيروت ـ 1421هـ): ج1، ص269؛ المالقي، أبو عبد الله بن محمّد بن يحيى (ت741هـ/1340م)، التمهيد والبيان في المقاتل الشهيد عثمان، تح: محمود يوسف زايد، دار الثقافة، (دوحة ـ1405هـ): ص47.
[141]) يُنظر: سكينة بنت الحسين÷: ص18 ـ20.
[142]) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص348؛ الزبيري، نسب قريش: ص59؛ الطبري، المنتخب: ص25؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص120؛ ابن منظور، محمّد بن مكرم بن علي (ت711هـ/1311م)، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، تح: روحية النحاس ورياض عبد الحميد مراد ومحمد مطيع، دار الفكر، (دمشق ـ 1984م): ج8، ص351.
[143]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج6، ص148؛ الدار قطني، أبو الحسن علي بن أحمد (ت385هـ/995م)، المؤتلف والمختلف، تح: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، دار الغرب الإسلامي، (بيروت ـ 1986م): ج2، ص1049؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص9؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج4، ص53.
[144]) ابن حبيب، المحبر: ص396 ـ397؛ ابن قتيبة الدينوري، أبو محمّد عبد الله بن مسلم (ت276هـ/889م)، المعارف، تح: ثروت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط2، (القاهرة ـ 1992م): ص213؛ البري، الجوهرة في نسب النبي: ج2، ص223؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة في معرفة الصحابة: ج1، ص355.
[145]) نور الله الحسيني، شرح إحقاق الحقِّ وإزهاق الباطل، تعليق: السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، منشورات آية الله العظمى المرعشي النجفي، (قم ـ د.ت): ج19، ص426.
[146]) يُنظر: السيّدة سكينة: ص119 ـ120.
[147]) باقر شريف، حياة الإمام الحسين بن علي× (دراسة وتحليل)، مطبعة الآداب، (النجف الأشرف ـ 1974م): ج1، ص189.
[148]) علي جواد، مقدِّمة في النقد الأدبي، المؤسَّسة العربية للدراسات والنشر، (بيروت ـ 1979م): ص340.
[149]) ابن حبيب، المحبر: ص396 ـ397.
[150]) العمري، المجدي في أنساب الطالبيين: ص92.
[151]) الزبيري، نسب قريش: ص59.
[152]) ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص9.
[153]) ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص346 ـ347.
[154]) المرعشي، شرح إحقاق الحق: ج19، ص426.
[155]) أحمد بن يحيى بن جابر (ت279هـ/892م)، أنساب الأشراف، تح: محمّد باقر المحمودي، مؤسَّسة الأعلمي، (بيروت ـ1974م): ص195.
[156]) الرباب بنت أُنيف بن عبيد بن مصاد بن كعب الكلابية، أم مصعب بن الزبير، يُنظر: الأصفهاني، معرفة الصحابة: ج1، ص112؛ الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة بغداد: ج15، ص128.
[157]) البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر، أنساب الأشراف: ص195.
[158]) البداية والنهاية: ج8، ص228.
[159]) البداية والنهاية: ج8، ص228.
[160]) يُنظر: ابن الأثير، عِزّ الدين أبو الحسن بن أبي المكرم (ت630هـ/1233م)، الكامل في التاريخ، تح: عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، (بيروت ـ 1997م): ج3، ص191؛ الباعوني، شمس الدين أبو البركات محمّد بن أحمد (ت871هـ/1466م)، جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب÷، تح: محمّد باقر المحمودي، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، (قم ـ 1416هـ): ج2، ص295.
[161]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص150؛ البيروتي، بشير يموت، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، المكتبة الأهلية، (بيروت ـ 1934م): ص172.
[162]) هو عبيد الله بن زياد، أمُّه مرجانة المجوسية، أصبح أمير العراق بعد أبيه زياد ابن أبيه، وهو ممن جُمع له المصران الكوفة والبصرة، وهو الذي أُتى برأس الحسين× لما قُتل فنكث على ثناياه، وقال في حسنه شيئاً، وقال أنس: كان أشبههم برسول الله|، وكان مخضوباً بالوسمة؛ قتله إبراهيم بن الأشتر سنة 66هـ؛ يُنظر: خليفة بن الخياط، أبو عمرو خليفة الشيباني العصفري (ت240هـ/854م)، تاريخ خليفة بن الخياط، تح: أكرم ضياء العمري، دار القلم ومؤسَّسة الرسالة، ط2، (دمشق ـ بيروت ـ1397هـ): ص263؛ الخطيب البغدادي، تالي تلخيص المتشابه، تح: مشهور بن حسن آل سلمان وأحمد الشقيرات، دار الأصمعي، (الرياض ـ 1417هـ): ج2، ص485؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص312.
[163]) أبو الفرج الأصفهاني، الاغاني: ج18، ص68؛ صدر الدين البصري، علي بن أبي الفرج بن الحسن (ت659هـ/1261م)، الحماسة البصرية، تح: مختار الدين أحمد، عالم الكتب، (بيروت ـ د.ت): ج1، ص204؛ ناصر، بتول قاسم، ملحمة كربلاء، (د. م ـ د.ت): ص145.
[164]) يُنظر: الإسفرايني، أبو إسحاق(ت ق 10 هـ/16م)، نور العين في مشهد الحسين×، المنار، تونس، د.ت: ص46.
[165]) عبد الله بن الحسين×، أُمُّه: الرباب بنت امرئ القيس، قُتل صغيراً، جاءته نشابة وهو في حجر أبيه، ذبحه عقبة بن بشر، يُنظر: الزبيري، نسب قريش: ص59؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص94.
[166]) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القريشي الهاشمي، أُمُّه ليلى بنت أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي، كان مولده في خلافة عثمان بن عفان، كنيته أبو الحسن وليس له عقب، وهو أوّل قتيل من بيت أبي طالب، حيث أخذ يشدُّ على الناس وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وربِّ البيت أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، فبصره مرّة بن منقذ بن النعمان العبدي، فطعنه، فصُرع وأحاط به الأعداء، فقطَّعوه بأسيافهم، فقال الحسين×: قتل الله قوماً قتلوك يا بني، ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول، على الدّنيا بعدك العفا، وقد ذكره معاوية يوماً فقال: فيه شجاعة بني هاشم، وسخاء أمية وزهو ثقيف، ولقد سمّاه المؤرخون علياً الأكبر تمييزاً له عن أخيه علي الأصغر زين العابدين×؛ يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص115؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص340؛ النويري، أحمد بن عبد الوهاب بن محمّد (ت733هـ/1333م)، نهاية الإرب في فنون الأدب، دار الكتب والوثائق القومية، (القاهرة ـ1423هـ): ج20، ص455؛ الزركلي، الأعلام: ج4، ص277.
[167]) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، اختلف المؤرخون في اسم أمِّه، فبعض قال: اسم أمِّه غزالة والبعض قال، سلافة بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى، والمشهور أنَّها شاه زنان بنت كسرى، لُقِّب زين العابدين لكثرة عبادته، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر، ومن سادات التابعين، كان يُضرب به المثل في الورع والحلم، وكان أفضل أهل زمانه، وصفه الزهري بأنَّه كثير المجالس كثير الفقه، لكنه قليل الحديث، كان مع أبيه في الطفِّ، وكان عمره 23 عاماً، كان مريضاً في كربلاء، عقب الحسين× منه، كان أبرَّ الناس بأمّه سلافة، وكان يُقال له ابن الخيرتين، توفي سنة أربع وتسعين للهجرة، ودفن في البقيع؛ يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص162 وص163؛ الطبري، المنتخب من ذيل المذيل: ص119؛ الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان (ت347 هـ/890م)، المعرفة والتاريخ، تح: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ د.ت): ج1، ص398؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص362.
[168]) جعفر بن الحسين×، أمُّه: قضاعية، وقيل: غير ذلك، تُوفي في حياة والده، ولا بقية له؛ يُنظر: الزبيري، نسب قريش: ص59؛ المفيد، الإرشاد: ج2، ص135؛ الطبرسي، تاج المواليد في المواليد: ص34؛ ابن عنبة، عمدة الطالب: ص192.
[169]) أمُّه أمُّ ولد، رُمي بسهم فأصابه فمات، واختُلف في مَن رماه، فقيل: حرملة الكاهلي، وقيل، عبد الله بن عقبة الغنوي؛ يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص92؛ القاضي النعمان، شرح الأخبار: ج3، ص178.
[170]) يُنظر: القاضي النعمان، شرح الأخبار: ج3، ص197.
[171]) فاطمة بنت الحسين بن علي، أمُّها أمُّ إسحاق التميمية، تزوَّجها ابن عمِّها الحسن بن الحسن السبط فولدت له عبد الله، ويُلقَّب بالمحض، ثمّ تُوفي، وكنايتها أمُّ عبد الله، وكانت تُلقَّب بفاطمة الصغرى للفرق بينها وبين جدتها الزهراء، وقيل: إنَّها تُلقَّب بالنبوية، عاشت أكثر من سبعين سنة حتّى أدركت عصر الإمام الصادق×؛ يُنظر: الزبيدي، نسب قريش: ص59؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج7، ص10 وص11؛ الدلفي، ملا رجي، سطور مع نساء مؤمنات، مؤسَّسة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ـ د.ت): ص59.
[172]) أُمُّ إسحاق بنت طلحة بن عبد الله، أُمُّها الجرباء بنت قسامة بن عبد الله، خطبها معاوية إلى ابنه يزيد من أخيها إسحاق بن طلحة؛ ولما تقدَّم الحسن×إليها، قال معاوية ليزيد: أعرض عن هذا، فتركها يزيد، وتزوّجها الحسن×، فولدت له طلحة؛ يُنظر: الزبيدي، نسب قريش: ص283؛ ابن الأثير، أسد الغابة: ج7، ص49.
[173]) الحسن بن علي بن أبي طالب، سيد شباب أهل الجنّة، وريحانة رسول الله|، والسيد المصلح بين الأُمَّة، وسبط من الأسباط، سمّاه النبي| حسناً، شبيه رسول الله| وحبيبه، سليل الهدى وحليف أهل التقى، وخامس أهل الكساء، وابن سيدة النساء، كان يخضب بسواد، يُكنَّى أبا محمّد، وُلِد سنة 3هـ عقَّ له رسول الله بكبش يوم سابعه، وحلق رأسه، وأمر أن يتصدّق بزنة شعره فضة، كان أشبه رسول الله ما بين الصدر إلى الرأس، وتواترت الآثار الصحاح عن النبي|، حيث قال: (إنَّ ابني هذا سيّد، وعسى الله أن يبقيه حتّى يصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين، سقته السُّمَّ زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس، فاشتكى منه، فكان يُوضع تحته طست وتُرفع أخرى نحو أربعين يوماً، كان يزيد وعد جعدة بالزواج منها إذا سمَّت الإمام الحسن×، فلمّا مات بعثت إليه تسأله الوفاء بالعهد فقال لها: إنا والله لم نرضك للحسن فنرضك لأنفسنا؛ يُنظر: ابن الجعد، علي بن الجعد بن عبيد (ت230هـ/845م)، مسند ابن الجعد، تح: عامر أحمد حيدر، مؤسَّسة نادر، (بيروت ـ 1990م): ص462؛ أبو نعيم الأصبهاني، معرفة الصحابة: ج2، ص654؛ ابن عبد البر، الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج1، ص384؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج13، ص284.
[174]) يُنظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص58.
[175]) يُنظر: البيهقي، لباب الأنساب والألقاب والأعقاب: ص43؛ الخلخالي، السيّدة رقية: ص165.
[176]) يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص347؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج7، ص180؛ النووي، أبو زكريا محي الدين (ت676هـ/1277م)، تهذيب الأسماء واللغات، تصحيح: شركة العلماء بمساعدة ادارة المطبعة المنيرية، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ د.ت): ج1، ص163؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص396؛ الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمّد (ت748هـ/1347م)، العبر في خبر من غبر، تح: أبو هاجر محمّد السعيد، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ د.ت): ج1، ص113.
[177]) عقبة بن سمعان: من أصحاب الإمام الحسين×، قيل: استُشهد بين يدي الحسين×، وقيل: فرَّ من المعركة ونجا، وقع التسليم عليه في الزيارة الرجبية، لقد ذكره الطبري وغيره من مؤرِّخي الواقعة ويُفهَم مما ذكروه أنَّه كان عبداً للرباب زوجة الإمام الحسين×، وأنَّه كان يتولّى خدمة فرسه وتقديمها له، ولما استُشهد الحسين× فرَّ على فرس، فأخذه أهل الكوفة، فزعم أنَّه عبد للرباب بنت امرئ القيس، زوجة الحسين× فأُطلِق، وجعل يروي الواقعة كما حدثت، ومنه أُخذت أخبارها؛ يُنظر: أبو مخنف، لوط بن يحيى بن سعيد بن خلف (ت157هـ/773م)، مقتل الحسين× ومصرع أهل بيته والصحابة في كربلاء، المشتهر بمقتل أبي مخنف، تح: ميرزا حسن الغفاري، المكتبة العامة للسيد شهاب الدين المرعشي النجفي، (قم ـ 1398 هـ): ص13؛ الخوئي، أبو القاسم الموسوي، معجم رجال الحديث وتفاصيل طبقات الرواة، تح: لجنة التحقيق، ط5، (د ـ م ـ 1992م): ج2، ص166 ـ170.
[178]) يُنظر: محمّد بن جرير بن زيد (ت310هـ/922م)، تاريخ الأُمم والملوك، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1407هـ): ج3، ص276.
[179]) يُنظر: البخاري، سرّ السلسلة العلوية: ص6؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص150؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج70، ص15؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج7، ص183؛ الحسيني، تاج الدين ابن محمّد، (كان حياً سنة 753هـ/1352م) غاية الإختصار في البيوتات العلوية المحفوظة من الغبار، تح: محمّد صادق بحر العلوم، (د. م ـ 1962م): ص41؛ العصامي، عبد الملك بن الحسين ابن عبد الملك (ت1111هـ/1699م)، سمط النجوم في أبناء الأوائل والتوالي، تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض، دار الكتب العلمية (بيروت ـ 1988م): ج4، ص126.
[180]) السيّدة سكينة: ص140.
[181]) سكينة بنت الحسين÷: ص26.
[182]) عدنان عبد النبي، سكينة بنت الحسين÷ نبراس هزم الإفتراء، دار حامد الإبراهيمي، (بغداد ـ د.ت): ص70.
[183]) هي تصغير دَبْرَة، وتعني النَّحلة الواحدة، سُمِّيت بذلك لتدبيرها العسل، وجاءت في حديث السيّدة لسعتها نحلة؛ لأنَّ النحل والزنابير سلاحها في أدبارها؛ يُنظر: الخطابي، أبو سليمان، حمد بن محمّد (ت388هـ/998م)، غريب الحديث، تح: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، خرّج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، دار الفكر، (د. ت ـ 1982م): ج3، ص211؛ الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر: ج1، ص410.
[184]) يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص207؛ ابن الأثير، محي الدين أبو السعادات المبارك (ت606هـ/1209م)، النهاية في غريب الحديث والأثر، تح: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطناجي، المكتبة العلمية، (بيروت ـ 1979م): ج2، ص99.
[185]) يُنظر: محمّد كاظم، زينب الكبرى من المهد إلى اللحد، مؤسّسة أمّ أبيها، (بغداد ـ 2013م): ص40.
[186]) الأغاني: ج16، ص152.
[187]) لم أعثر على ترجمته.
[188]) جلاهقات: من جلاهق وهو لفظ فارسي معرَّب، جمعه جلاهقات، هو طين مدوّر يُرمي به الطير، ثمّ صارت كرات من الحجارة؛ يُنظر: الوحش، عبد الله بن بري بن عبد الجبار (ت852هـ/1186م)، في التعريب والمعرب، تح: إبراهيم السامرائي، مؤسَّسة الرسالة، (بيروت ـ د.ت): ص61؛ دهمان، محمّد أحمد، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، (بيروت وسوريا ـ 1990م): ص53.
[189]) يُنظر: ابن سعد، محمّد بن منيع (ت230هـ/844م)، الطبقات الكبير، تح: علي محمّد عمر، مكتبة الخارجي، (القاهرة ـ 2001م): ج6، ص47؛ الجلالي، محمّد رضا، الإمام الحسين× سماحته وسيرته، دار المعروف، (قم ـ د.ت): ص100.
[190]) ابن رشيق، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني (ت463هـ/1070م)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، ط5، (د. م ـ 1981م): ص35ـ ص36؛ ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله (ت660هـ/1209م)، بغية الطالب في تاريخ حلب، تح: سهيل زكار، دار الفكر، (د. م ـ د.ت): ج6، ص2594.
[191]) يُنظر: النقدي، جعفر، زينب الكبرى بنت الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب^، منشورات المكتبة الحيدرية، ط4، (النجف ـ د.ت): ص19.
[192]) يُنظر: الهاشمي، عبد المنعم، السيّدة سكينة G، دار ومكتبة الهلال، (بيروت ـ 2003م): ص19.
[193]) سعيد، عقائل قريش، المطبعة العصرية، ط2، (الموصل ـ 1955م): ص20.
[194]) يُنظر: عبد الله، تاريخ الحسين× نقد وتحليل، دار الجديد، (د. م ـ 1994م): ص165.
[195]) يُنظر: ضميرية، عثمان جمعة، عمل المرأة والإختلاط وأثره في انتشار الطلاق، بحث منشور في مجلة البحوث الإسلامية، عدد77، سنة 1426هــ1427هـ: ص349.
[196]) يُنظر: الموسوي، جبار السيد موسى، الإمام الحسين×، مكتبة الأصدقاء، (بغداد ـ2011م): ص64.
[197]) يُنظر: حسن، المرأة المسلمة، بحث منشور في مجلة المنار، عدد 35، سنة 1359 هـ: ص765.
[198] يُنظر: الأزهري، تهذيب اللغة: ج4، ص97.
[199] يُنظر: مطهري، مرتضى، مسألة الحجاب، الدار الإسلامية، ط4، (بيروت ـ 2008م): ص60.
[200] يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص125؛ الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص615؛ بيضون، لبيب، موكب الإباء من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، مؤسَّسة البلاغ، (بيروت ـ 2009م): ص53.
[201] يُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص101 ـ 102.
[202] يُنظر: الحكيم، محمّد باقر، الإمام الحسين×، مطبعة العترة الطاهرة، (النجف الأشرف ـ 2008م)، 260 ـ 262.
[203]) سهل بن سعد بن مالك بن خالد، من مشاهير الصحابة، كان اسمه حزنا، فغيّره النبي|، مات سنة إحدى وسبعين، عاش مائة سنة، يُنظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة: ج3، ص167.
[204] يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص127 ـ 128؛ الأمين، لواعج الأشجان، 220 ـ 221؛ الكوراني، علي الكوراني، جواهر التاريخ، دار الهدى، (د. م ـ 1427هـ): ج4، ص82 ـ 83.
[205] يُنظر: المقرّم، عبدالرزاق، مقتل الحسين×، منشورات الفجر، (بيروت ـ 2008م): ص326.
[206] يُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطوف: ص101 ـ 102.
[208] يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص150؛ ابن الصبان، أبو العرفان محمّد بن علي المصري (ت1206هـ/1791م)، اسعاف الراغبين في سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرين المطبوع بهامش نور الأبصار للشبلنجي، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ د.ت): ص210؛ فضل الله، مريم نور الدين، حفيدة الزهراء سكينة.. والشبهات، بحث منشور في مجلة العرفان، العدد العاشر، بيروت، سنة 1983م: ص18.
[209] يُنظر: الجرجاني، علي بن محمّد بن علي (ت816هـ/1413م)، التعريفات، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1983م): ص24/1413م.
[211] يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص194؛ البحراني، العوالم: ص420.
[212] يُنظر: السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: ج1، ص313.
[213] السُّفرَة: طعام المسافر؛ يُنظر: الرسي، المحكم والمحيط والأعظم: ج8، ص479.
[214] يُنظر: ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت597هـ/1200م)، صفة الصفوة، تح: أحمد ابن علي، دار الحديث، (القاهرة ـ 2000م): ج1، ص355؛ ابن طلحة الشافعي، كمال الدين محمّد (ت652هـ/1254م)، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، تح: ماجد بن أحمد العطية، (د. م ـ د.ت)، 415؛ سبط بن الجوزي، تذكرة الخواص: ص620؛ الاربلي، علي بن عيسى بن أبي الفتح (ت693هـ/1293م)، كشف الغمّة في معرفة الأئمة، دار الأضواء، ط2، (بيروت ـ 1985م) ج2، ص290.
[215] يُنظر: ابن قدامة، أبو محمّد عبد الله بن أحمد (ت620هـ/1223م)، المغني، دار الكتاب العربي، (بيروت ـ د.ت): ج3، ص446؛ ابن قدامة، عبد الرحمن بن عمر بن أحمد (ت682هـ/ 1283م)، الشرح الكبير على متن المقنع، دار الكتاب العربي، (بيروت ـ د.ت): ج3، ص451.
[216] يُنظر: الحلي، جمال الدين بن الحسن بن يوسف (ت726هـ/1325م)، تذكرة الفقهاء، مؤسَّسة آل البيت^ لإحياء التراث، (قم ـ 1417هـ): ج8، ص215.
[217] يُنظر: البسيوني، حسن، سكينة بنت الحسين÷ بين الناس ومع الله، بحث منشور في مجلة الأزهر، سنة 1975م: ج8، ص894ـ 895.
[218] يُنظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص394؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج15، ص183؛ اليافعي، مرآة الجنان: ج1، ص198.
[219] يُنظر: ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص229.
[220] يُنظر: النووي، تهذيب الأسماء واللغات: ج1، ص163.
[221] يُنظر: ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب: ج2، ص82.
[222] يُنظر: ابن حبان، الثقات: ج4، ص352؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج7، ص180؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص396؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج5، ص263؛ اليافعي، مرآة الجنان: ج1، ص19؛ ابن تغري بردي، النجوم الزهرة: ج1، ص26؛ الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار: ج5، ص218.
[223] شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب إمام ثقة، مقرئ المدينة وقاضيها، مولى أمِّ سلمة مسحت على رأسه ودعت له بخير، يُنظر: ابن الجزري، محمّد بن محمّد بن يوسف (ت833هـ/142م)، غاية النهاية في طبقات القراء، مكتبة ابن تيمية، (د. م ـ د.ت): ج1، ص329.
[224] يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص348؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص127.
[225] خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ولي المدينة لهشام بن عبد الملك سنة 113هـ؛ يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج96، ص170.
[226] الأغاني: ج16، 181 ـ182.
[227] يُنظر: ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص333؛ النووي، تهذيب الأسماء واللغات: ج1، ص343؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج6، ص260؛ اليافعي، مرآة الجنان: ج1، ص151.
[228] طبرية: وهي بليدة مطلّة على البحيرة وهي من أعمال الأردن، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص17.
[229]) يُنظر: ابن بطوطة، محمّد بن عبد الله
بن محمّد (779هـ/1377م)، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ج1، ص323؛ عبد الهادي، يوسف، ثمار المقاصد
في ذكر المساجد، مكتبة لبنان، (د. م ـ 1975م):
[230] معجم البلدان: ج4، ص19.
[231] أعيان الشيعة: ج3، ص492.
[232] يُنظر: ابن الجوزي، المنتظم: ج7، ص180؛ اليافعي، مرآة الجنان: ج1، ص199.
[233] الاصبغ بن عبد العزيز بن مروان، سكن مصر مع أبيه حتّى مات فيها قبل أبيه بعشرين يوماً؛ يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج9، ص170.
[234] يُنظر: ابن عثمان الشارعي، موفق الدين بن محمّد بن عبد الرحمن (ت615هـ/1218م)، مرشد الزوار إلى قبور الأبرار، الدار المصرية اللبنانية، (القاهرة ـ1415هـ): ص154.
[235] يُنظر: ابن عثمان الشارعي، مرشد الزوار: ج1، ص155.
[236] يُنظر: القزويني، زينب الكبرى: ص119.
[237] يُنظر: المرأة العظيمة: ص254.
[238] يُنظر: الجلالي، محمّد حسين الحسيني، مزارات أهل البيت وتاريخها، (بيروت ـ 1995م): ص228.
[240] يُنظر: بيضون، لبيب، موسوعة كربلاء، مؤسّسة الأعلمي، (بيروت ـ 2006م): ج2، ص630.
[241] يُنظر: عثمان، هاشم، مشاهد ومزارات آل البيت^ في الشام، مؤسّسة الأعلمي، (بيروت ـ 1994م): ص35.
[242]) يُنظر: النعيمي، عبد القادر بن محمّد (ت927هـ/1520)، الدارس في تاريخ المدارس، تح: إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، (د. م ـ1990م): ج2، ص261.
[243] يُنظر: محمّد، سعاد ماهر، مساجد مصر وأولياؤها الصالحون، المجلس الأعلى للشؤون المصرية، إشراف: محمّد توفيق عويضة، (مصر ـ د.ت): ج1، ص102.
[244] يُنظر: مبارك، علي، الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة، دار الكتب، (د. م 1969م): ج2، ص186.
[245] يُنظر: أبو كف، أحمد، آل بيت النبي| في مصر، دار المعارف، (د. م ـ د.ت): ص98.
[246] يُنظر: ماهر، سعاد، وآخرون، أهل البيت في مصر، دار الهدف، (القاهرة ـ 2001م): ص196.
[247]) يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص271 وما بعدها؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص324 وما بعدها؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص129 وما بعدها.
[248]الدينوري، الأخبار الطوال: ص244؛ مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد(ت421هـ/1030م)، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تح: أبو القاسم إمامي، دار مروش، ط2، (طهران ـ2000م): ج2، ص58.
[249] يُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف، 40؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص364؛ الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص593.
[250]) يُنظر: القندوزي، ينابيع المودة: ج3، ص60.
[251] حياة الإمام الحسين×: ج2، ص16.
[252] يُنظر: الحسن، عبد الله، ليلة عاشوراء في الحديث والأدب، مطبعة بهن، (د. م ـ 1418هـ): ص109.
[253] يُنظر: جعفر، مرتضى، مأساة الزهراء‘ (شبهات... وردود)، دار السيرة، (بيروت ـ1997م): ج1، ص266.
[254] يُنظر: هاشم معروف، من وحي الثورة الحسينية، دار التعارف، (سوريا ـ 1994م): ص51.
[255] يُنظر: المقدسي، المطهر بن طاهر (ت355هـ/965م)، البدء والتاريخ، مكتبة الثقافة الدينية، (بور سعيد ـ د.ت): ج6، ص23؛ مسكوية، تجارب الأمم وتعاقب الهمم: ج4، ص214؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمّد بن محمّد (ت808هـ/1405) العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، تح: خليل شحادة، دار الفكر، ط2، (بيروت ـ 1988م): ج3، ص40.
[256] المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص329؛ الميانجي، علي الأحمدي، مكاتيب الرسول|، دار الحديث، (طهران ـ 1419هـ): ج2، ص366.
[257] يُنظر: زينب بنت علي بن أبي طالب، أمُّها فاطمة بنت رسول الله، تزوّجت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فولدت له علياً، وعوناً الأكبر، وعباساً، ومحمداً، وأمَّ كلثوم، وكانت مع أخيها الحسين× إلى أن قُتل وحُملت إلى دمشق، وحضرت عند يزيد، وكلامها مشهور مذكور في التواريخ، وهو يدلُّ على عقل وقوة جنان؛ يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص340؛ ابن الأثير، أُسد الغابة: ج7، ص134.
[258] يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص347 وما بعدها؛ يُنظر: ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبه الله (ت475هـ/1082م)، الاكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1990م): ج4، ص316؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج68، ص204 وما بعدها؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج5، ص263 وما بعدها؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج15، ص182.
[259] يُنظر: الدينوري، الأخبار الطوال: ص244؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص296؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص149؛ التستري، جعفر، الأيام الحسينية، ترجمة: إبراهيم رفاعة، دار المرتضى، (بيروت ـ1993م): ص32.
[260] ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص228؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص374؛ الهاشمي، السيّدة سكينة: ص27.
[261] يُنظر: الدينوري، الأخبار الطوال: ص253.
[262] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص310؛ الحساني، محمّد رضا، الحسين× بن علي، بحث منشور في مجلة القادسية، النجف الأشرف، العدد الخامس، السنة الرابعة، 1366هـ: ص1.
[263] يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص315؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج5، ص337؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص166؛ ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص191.
[264] أمُّ كلثوم: بنت علي بن أبي طالب، أُمُّها فاطمة الزهراء بنت رسول الله، وُلدت قبل وفاة رسول الله|، يُنظر: ابن عبد البر، الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ج4، ص1955.
[265] البقرة: آية 57.
[266] يُنظر: الفاضل الدربندي، آغا ا بن عابد الشيرواني (ت1285هـ/1868م)، إكسير العبادات في أسرار الشهادات (المقتل الملم بمأساة الحسين×)، تح: محمّد جمعة بادي وعبّاس ملا عطية الحميري، شركة المصطفى للخدمات الثقافية، (د. م ـ 1999م): ج2، ص222 ـ223.
[267]) يُنظر: الفاضل الدربندي، إكسير العبادات: ج2، ص222 ـ223.
[268]) المصدر نفسه.
[269]) المصدر نفسه.
[270] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص67.
[271] يُنظر: الطبري، أبو جعفر محمّد بن جرير (ت310هـ/923م)، استشهاد الحسين ويليه رأس الحسين لابن تيمية، تح: السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، ط2، (بيروت ـ1988م): ص136؛ أبو نصر البخاري، سر السلسة العلوية: ص30؛ المشهدي، محمّد بن جعفر (ت ق 6 هـ/1213م)، المزار، تح: جواد القيومي الأصفهاني، مؤسَّسة النشر الإسلامي، (قم ـ 1419هـ): ص487؛ الفتلاوي، علي، المرأة في حياة الإمام الحسين×، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، (كربلاء ـ د.ت): ص152.
[272] زينب الكبرى: ص105.
[274] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص334؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص90؛ الشاكري، حسين، شهداء أهل البيت^ قمر بني هاشم، مطبعة ستارة، (د. م ـ1420ه): ص98، الشريفي، محمود وآخرون، موسوعة كلمات الإمام الحسين×، دار المعروف، ط3، (د. م ـ 1995م): ص569.
[275] القاضي النعماني، شرح الأخبار: ج3، ص193؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص42، المقرّم، العبّاس: ص256.
[278] يُنظر: الدينوري، الأخبار الطوال: ص255.
[279] فاضل الدربندي، إكسير العبادات: ج2، ص725.
[280] الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص343؛ فاضل الدربندي، إكسير العبادات: ج2، ص725؛ السماوي، أنصار الحسين×: ص54.
[281] يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص340.
[282]المجلسي، بحار الأنوار: ج 45، ص198؛ القندوزي، ينابيع المودة: ج3، ص95؛ اللطيفي، محمود، وآخرون، موسوعة شهادة المعصومين^، انتشارات نور السجاد، (قم ـ 1381ش): ص401.
[283] الطفل الرضيع: هو عبد الله بن الحسين×، أمُّه الرباب بنت امرئ القيس، وهو شقيق سكينة، كان في واقعة الطّف لا يزال طفلاً رضيعاً، فقد اصطحبه الإمام الحسين× معه إلى كربلاء مع أمِّه وأخواته كما أوضحنا، فلما آيس الحسين× من نفسه، ذهب إلى فسطاطه فطلب الطفل ليودّعه، فجاءت به أخته زينب، وخرج به إلى القوم؛ لكي يسقيه الماء فوضعه في حجره، فإذا هو ينظر إليه إذ أتاه سهم، فوقع في نحره؛ يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص173ـ174؛ الزبيري، نسب قريش: ص59؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص343؛ أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص94؛ السماوي، ابصار العين: ص54.
[285]ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص257؛ الأمين، محسن الأمين، لواعج الأشجان في مقتل الحسين×، منشورات مكتبة بصيرتي، (قم ـ 1331هـ): ص184؛ البياتي، جعفر، الأخلاق الحسينية، أنوار الهدى، (د. م ـ 1418هـ)؛ الخلخالي، السيّدة رقية: ص154.
[286] لو تُرك القطا لَنامَ: هو مثل يضربه الرجل عندما يؤمن بترك ما لا يصل إلى تركه، فما هو مؤديه، يُنظر: الأنباري، محمّد بن قاسم بن محمّد (ت328هـ)، الزاهر في معاني كلمات الناس، تح: حاتم صالح الضامن، مؤسّسة الرسالة، (بيروت ـ 1992م): ج2، ص273.
[287] يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص47.
[288] سبهر، لسان الملك ميرزا محمّد تقي، (1216هـ/1801م)، ناسخ التواريخ حياة الإمام سيد الشهداء الحسين×، ترجمة: سيد علي جمال أشرف، انتشارات مدين، (قم ـ 2007م): ج2، ص21.
[289] التبّان: هي سراويل صغيرة، يُنظر: الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر، (817هـ/1414م)، القاموس المحيط، تح: مكتبة التراث، بإشراف: محمّد نعيم العرقسوسي، مؤسّسة الرسالة، ط8، (بيروت ـ 2005م): ص1183.
[290] يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص333؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص257.
[291]) ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص257؛ القندوزي، ينابيع المودة: ج3، ص79؛ الشاكري، حسين، العقيلة والفواطم، مطبعة ستارة، (قم ـ د.ت): ص176.
[292]) يُنظر: من أخلاق الإمام الحسين×: ص249، 250.
[293] يُنظر: الطبري، استشهاد الحسين: ص140؛ الأسفرايني، نور العين في مشهد الحسين×: ص48 وص49.
[295] يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج43، ص179؛ الخوئي، ميرزا حبيب الله الهاشمي (1324هـ/ 1916م)، منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، تصحيح: إبراهيم الميانجي، منشورات دار الهجرة، ط4، (قم ـ د.ت): ج13، ص28؛ القمي، عبّاس (ت1395هـ/1975م)، الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية، مؤسّسة النشر الإسلامي (قم ـ 1417هـ): ص62.
[296] يُنظر: الواحدي، محمّد رضا، السيّدة المجهولة، لمحات من حياة السيّدة سكينة بنت أمير المؤمنين الإمام علي ابن أبي طالب والسيّدة فاطمة الزهراء^، تعريب وإضافات: السيد رضي السيد أحمد الواحدي، وزارة الإعلام، (داريا ـ 2009م): ص35.
[297] يُنظر: الأسفرايني، نور العين: ص46ـ47.
[298] يُنظر: ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص257؛ القندوزي، ينابيع المودة: ج3، ص79.
[300] يُنظر: الأسفرايني، نور العين في مشهد الحسين×: ص52.
[301] ينظر: الصدوق، الأمالي: ص226؛ ابن الفتال النيسابوري، روضة الواعظين: ص189؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج44، ص322؛ القندوزي، ينابيع المودة: ج3، ص84 ـ 85.
[302] القندوزي، ينابيع المودة: ج3، ص85؛ زميزم، سعيد شيد، نساء حول الحسين×، مراجعة وتح: محمّد صادق التاج، دار الجوادين، (د. م ـ 2011م): ص60؛ الشبستري، عبد الحسين، مشاهير شعراء الشيعة، المكتبة الأدبية المختصة، (قم ـ 1421هـ): ج1، ص211.
[304]الرثاء: يعني البكاء على الميت وتعدُّد محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعراً، يُنظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة: ج6، ص23520.
[305] يُنظر: الخطيب، بشرى محمّد علي، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، مطبعة الإدارة المحلية، (بغداد ـ 1977م): ص51.
[306] القندوزي، ينابيع المودة: ج3، ص86.
[307] المرعشي، شرح إحقاق الحق: ج33، ص758.
[308] المصدر نفسه.
[309] المصدر نفسه.
[310] المصدر نفسه.
[311] الزجاجي، عبد الرحمن بن إسحاق (ت337هـ/949م)، الأمالي، تح: عبد السلام هارون، دار الجيل، ط2، (بيروت ـ 1987م): ص168ـ169؛ أرفع، فاطمة السادات، معجم الشاعرات النبي| في القرنين الأول والثاني الهجريين، (د. م ـ د.ت): ص149.
[312] يُنظر: الزجّاجي، الأمالي: ص168.
[313] يُنظر: إبراهيم، ريكان، نقد الشعر في المنظور النفسي، دار الشؤون الثقافية، (بغداد ـ 1989م): ص79؛ جاسم، مجبل عزيز، مراثِي الإمام الحسين× في العصر الأموي (دراسة فنية)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الكوفة، 2005م: ص27ـ41.
[314] الطريحي، فخر الدين بن محمّد (ت1085هـ/674م)، المنتخب للطريحي، موسوعة الأعلمي للمطبوعات، (بيروت ـ د.ت): ج2، ص466 ـ467.
[315] يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×، 190؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص259.
[316] يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، 334؛ مسكويه، تجارب الأمم وتعاقب الهمم: ج2، ص81.
[317] يُنظر: ابن نما الحلي، مثير الأحزان: ص58.
[318] يُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص79؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص59.
[319] الطبرسي، ميرزا حسين النوري (ت1320هـ/1902م)، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تح: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، (بيروت ـ 1988م): ج17، ص26.
[320] الكفعمي، تقي الدين إبراهيم (ت905هـ/1498م)، جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية المشهر بالمصباح، مؤسّسة الأعلمي لمطبوعات، ط3، (بيروت ـ 1983م): ص741.
[321] محمّد مهدي، شجرة طوبى، منشورات المكتبة الحيدرية، ط5 (النجف الأشرف ـ 1385هـ): ج2، ص431.
[323] السيّدة رقية: ص159ـ160.
[324] يُنظر: الطبري، استشهاد الحسين: ص150؛ بيضون، موكب الأباء: ص152.
[325] ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج6، ص448؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج3، ص303.
[326] يُنظر: الأميني، محمّد أمين، الأيام الشامية من عمر النهضة الحسينية، دار الولائي، (بيروت ـ 2006م): ص209.
[327] يُنظر: الطبراني، المعجم الكبير: ج3، ص104؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص189.
[328] يُنظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص189؛ الصدوق، الأمالي: ص230ـ231؛ ابن الفتال النيسابوري، روضة الواعظين: ص191؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص156.
[329] السيّدة رقية: ص108.
[331] يُنظر: الصدوق، الأمالي: ص230ـ231؛ ابن الفتال النيسابوري، رواض الواعظين: ص191.
[332] يُنظر: الطبري، استشهاد الحسين: ص151؛ الطريحي، المنتخب: ص486.
[333] يُنظر: الطبري، استشهاد الحسين: ص152؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص189؛ الطريحي، المنتخب: ص486.
[334]) عاتكة ابنة يزيد تزوجت عبد الملك فأولدت كلاً من يزيد، ومروان، ومعاوية، يُنظر: ابن سعد الطبقات الكبرى: ج5، ص173.
[335] يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص217؛ الطبري، استشهاد الحسين: ص154؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص189؛ العصامي، سمط النجوم: ج3، ص183؛ الفاضل الدربندي، إكسير العبادات: ص639ـ640.
[336] يُنظر: الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر: ج4، ص85.
[337] يُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص109؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص141.
[338] يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص217؛ الطبري، استشهاد الحسين: ص154؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص189؛ النويري، نهاية الأرب: ج20، ص470؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص140ـ141؛ البحراني، العوالم: ص441.
[340] الطريحي، المنتخب: ج2، ص486.
[341] يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج25، ص196؛ البحراني، مدينة المعاجز: ج4، ص137.
[342] يُنظر: أبو مخنف، مقتل الحسين×: ص217؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص189؛ النويري، نهاية الارب: ج20، ص470؛ الفاضل الدربندي، إكسير العبادات: ج3، ص679.
[343] جابر بن عبد الله الأنصاري: هو من أصحاب النبي شهد العقبة مع أبيه، كنيته أبو عبد الله، استغفر له النبي|، وشهد معهُ غزواته، مات في سن ثمان أو تسع وسبعين؛ يُنظر: ابن حبان، محمّد بن حبان بن أحمد (ت354هـ/965م) الثقات، دائرة المعارف العثمانية، (الهند ـ 1973م): ج3، ص51.
[344] يُنظر: ابن نما الحلي، مثير الأحزان: ص86؛ ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص114.
[345] الفاضل الدربندي، إكسير العبادات: ج3، ص715.
[346] يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص335؛ النصراوي، حسن عبد الأمير، رأس الحسين× من الشهادة إلى الدفن، (بيروت ـ 2000م): ص71.
[347] يُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص84.
[348] السيّدة رقية: ص100.
[349] يُنظر: الفاضل الدربندي، إكسير العبادات: ج3، ص515.
[350] يُنظر: الحلو، عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة: ص40.
[351] يُنظر: الصفار، المرأة العظيمة: ص195.
[352] يُنظر: حنفي، حسين، من العقيدة إلى الثورة، دار التنوير، (بيروت ـ 1988م): ج3، ص38.
[353] يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص137.
[354] يُنظر: الحميري، أبو العبّاس عبد الله بن جعفر (ت304هـ/916م)، قرب الإسناد، تح: مؤسّسة إحياء التراث، (قم ـ 1413هـ): ص26؛ الصدوق، الأمالي: ص230؛ الفتال النيسابوري، روضة الواعظين: ص191؛ التوبلي، هاشم البحراني الموسوي (ت1107هـ/1695م)، غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام عن طريق الخاص والعام، تح: السيد علي عاشور، (د. م ـ د.ت): ص243؛ الريشهري، محمّد، أهل البيت في الكتاب السنة، دار الحديث، ط2، (د. م ـ 1375ش): ص60.
[355]) يُنظر:عبد الرزاق، زياد طارق، أثر وسائل الإعلام في السياسة، بحث منشورات في مجلة الجامعة الإسلامية، عدد 23، سنة 2009 م: ص287.
[356] يُنظر:الحداد، كفاح، نساء الطفوف، تقدم: السيد محمّد علي الحلو، العتبة الحسينية المقدّسة، (كربلاء ـ 2011م): ص120.
[357] يُنظر: النقدي، زينب الكبرى: ص96 ـ 97.
[358] يُنظر: المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص147؛ الخلخالي، السيّدة رقية: ص180.
[359] بشير بن جذلم: هو رسول الإمام السجاد× إلى أهل المدينة، وكان شاعراً وراثياً؛ يُنظر: الشاهرودي، علي النمازي، مستدركات علم الرجال الحديث، مطبعة حيدري، (طهران ـ د.ت): ج2، ص37.
[360] ابن نما الحلي، نجم الدين محمّد بن جعفر (ت 645هـ/1247م)، مثير الأحزان، المطبعة الحيدرية، (النجف الأشرف ـ 1950م): ص90؛ ابن طاووس، علي بن موسى بن جعفر، (664هـ/1265م)، اللهوف في قتلى الطفوف، أنوار الهدى، (قم ـ 1417هـ): ص115.
[361] يُنظر: ابن نما الحلي، مثير الأحزان: ص90؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص147؛ العسكري، مرتضى، معالم المدرستين، مؤسّسة النعمان، (بيروت ـ1991م) ج3، ص169.
[362] يُنظر: ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص121.
[363] ابن نما الحلي، جعفر بن محمّد (ت645هـ/1247م)، ذوب النضار في شرح الثار، تح: فارس حسون كريم، مؤسّسة النشر الإسلامي، (د. م ـ 1416هـ): ص144؛ الأمين، أعيان الشيعة: ج1، ص587.
[364] المجلسي، بحار الأنوار: ج45، ص386؛ الخرسان، محمّد مهدي، موسوعة عبد الله بن عبّاس (حبر الأمّة وترجمان القرآن)، مركز الأبحاث العقائدي، (قم ـ د.ت): ج5، ص266.
[365] زرارة بن عبد الله بن أسيد، روى عن سعيد بن المسيب ذكروه باختصار جداً؛ يُنظر: ابن حبان، الثقات: ج6، ص32.
[366] ابن قولويه، أبو القاسم جعفر بن محمّد (ت367هـ/977م)، كامل الزيارات، تح: جواد الفيومي، مؤسّسة النشر الإسلامي، (د. م ـ 1417هـ): ص168؛ النووي، مستدرك الوسائل: ج1، ص391؛ المقرّم، مقتل الحسين×: ص34.
[367] يُنظر: الشاكري، العقيلة والفواطم: ص182.
[368] يُنظر: العبيدلي، يحيى بن الحسن بن جعفر (ت277هـ/890م)، أخبار الزينبيات، تح: حسن محمّد قاسم، ط2، (مصر ـ 1934م): ص122؛ العبودي، هناء سعد، السيّدة زينبB، ودورها في أحداث عصرها، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الكوفة، كلية الآداب، 2006: ص99.
[369] يُنظر: محمّد محمّد صادق، أضواء على ثورة الإمام الحسين×، د.م، ط2، (النجف ـ د.ت): ص113.
[370] يُنظر: الطبرسي، محمّد جعفر، وقائع الطريق من كربلاء إلى الشام، (قم ـ1382هـ): ج5، ص9.
[371] يُنظر: الدينوري، أبو حنيفة أحمد بن داود (ت282هـ/895م)، الأخبار الطوال، تح: عبد المنعم عامر، مراجعة: جمال الدين الشيال، دار إحياء الكتاب العربي، (القاهرة ـ 1960م): ص244؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص296؛ الطريحي، المنتخب للطريحي: ج2، ص421.
[372] يُنظر: الدينوري، الأخبار الطوال: ص253.
[373] يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص310؛ الحساني، محمّد رضا، الحسين بن علي، بحث منشور في مجلة القادسية، النجف الأشرف، العدد الخامس، السنة الرابعة، 1366هـ: ص1.
[374] نوري، مستدرك الوسائل: ج17، ص265؛ القمي، عبّاس (ت1395هـ/1975م) نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم، دار المرتضى، (بيروت ـ 2008م): ص164.
[375] الصدوق، الأمالي: ص230ـ231؛ ابن الفتال النيسابوري، محمّد بن أحمد بن علي (ت 508هـ/1114م)، روضة الواعظين، الدمعة الناطقة، ومجالس الخطباء، وروضة المستمعين في ورد من محمّد وآله الطاهرين، تقديم: محمّد مهدي السيد حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضي، (د. م ـ د.ت): ص191.
[376] يُنظر: الورداني: صالح، السيف والسياسة صراع بين الإسلام النبوي والإسلام الأموي، دار الجسام، (القاهرة ـ 1996م): ص193.
[377] الفيض الكاشاني، محمّد محسن (ت1091هـ/1680م)، الوافي، تح: ضياء الدين الحسيني، (د. م ـ د.ت): ج1، ص279؛ الحسني، هاشم معروف، تاريخ الفقه الجعفري، تح: محمّد جواد مغنية، دار النشر للجامعيين، (د. م ـ د.ت): ص199.
[378] يُنظر: الورداني، السيف والسياسة: ص43.
[379] يُنظر: علي، موسى محمّد، عقيلة الطهر والكرم السيّدة زينبB، (مصرـ د.ت): ص72.
[380] يُنظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص394؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج15، ص183؛ اليافعي، مرأة الجنان: ج1، ص198؛ الدلفي، سطور مع نساء مؤمنات: ص54.
[381] يُنظر: ابن ماكولا، الاكمال في رفع الإرتياب: ج4، ص316.
[382] الثقات: ج4، ص352.
[383] الطبراني، المعجم الكبير: ج3، ص132؛ السخاوي، علي بن محمّد بن عبد الصمد (ت643هـ/1245م): جمل القراء وكمال الاقراء، تح: مروان العطية محسن خرابة، دار المأمون، (بيروت ـ 1997م): ص200؛ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت774هـ/1372م)، جامع المسانيد والسنن الهادي لأقوم سنن، تح: عبدالملك بن عبد الله الدهيش، دار خضر، (مكة المكرمة ـ 1998م): ج2، ص493؛ السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت911هـ/1505م)، جامع الأحاديث، إشراف: علي جمعة، (د. م ـ د.ت): ج12، ص145.
[384] الفاضل الدربندي، إكسير العبادات: ج2، ص223؛ الشريفي، موسوعة كلمات الإمام الحسين×: ص483.
[385] الخركوشي، عبد الملك بن محمّد بن إبراهيم (ت407هـ/1016م)، شرف المصطفى، دار البشائر الإسلامية، (مكة ـ1424هـ): ج6، ص14؛ القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق المصطفى: ج1، ص340؛ القسطلاني، أحمد بن محمّد بن أبي بكر (ت923هـ/1516م)، المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، المكتبة التوفيقية، (القاهرة ـ د.ت): ج2، ص473؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج65، ص77؛ الشاهرودي، مستدرك سفينة البحار: ج6، ص114ـ115؛ الأبطحي، مرتضى، الشيعة في أحاديث فريقين، مطبعة الأمير، (د. م ـ 1416هـ):ص119.
[386] الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي، (رقم الحديث202): ج1، ص167؛ الصنعاني، المصنف، (رقم الحديث9745): ج5، ص405؛ الأميني، عبد الحسين أحمد (ت1392هـ/1972م)، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، دار الكتاب العربي، ط4، (بيروت ـ1977م): ج1، ص197؛ الميلاني، علي، خلاصة عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار، مؤسّسة البعثة، (قم ـ 1404هـ): ج7، ص188.
[387]) يُنظر: ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص333؛ النووي، تهذيب الاسماء واللغات: ج1، ص343؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج6، ص26.
[388]) يُنظر: إسماعيل، علي فهمي، مدخل إلى علم النفس العام، المكتب الجامعي الحديث، (د. م ـ 1985م): ص67.
[389]) يُنظر: الحلو، عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة: ص21 ـ22.
[390]) يُنظر: الحلو، محمّد علي، تاريخ الحديث النبوي بين سلطة النص ونص السلطة، مكتبة الإمام الصادق×، ط5، (النجف ـ د.ت): ص240.
[391]) يُنظر: السبعاوي، طه عبد الله محمّد وآخرون، الحديث الضعيف ومدى الاحتجاج به في الفكر الإسلامي، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، العدد 25، (بغداد ـ 2010م): ص102.
[392]) المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين (ت346هـ/957م)، منشورات دار الهجرة، ط2 (قم ـ 1984): ج2، ص343.
[393]) شذرات من فلسفة الحسين×: ص148.
[394]) الطبقات الكبرى: ج5، ص460.
[395]) محمّد بن عمر بن موسى (ت322هـ/933م)، الضعفاء، تح: مازن السرساوي، دار ابن عباس، ط2، (مصر ـ 2008م): ج6، ص25.
[396]) أبو أحمد عبد الله بن عدي (ت365هــ/975م)، الكامل في ضعفاء الرجال، تح: عادل أحمد عبد الوجود وعلي محمّد معوّض، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1997م): ج8، ص84.
[397]) الفهرست: ص140.
[398]) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت597هـ/1200م)، الضعفاء والمتروكون، تح: عبدالله القاضي، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1406هـ): ج3، ص12.
[399]) الكامل في التاريخ: ج6، ص132.
[400]) يُنظر: شمس الدين أبو عبد الله محمّد (ت748هـ/1347م)، المغني في الضعفاء، تح: نور الدين عتر، د. م ط، (د. م ـ د.ت): ج2، ص660.
[401]) يُنظر: المقريزي، أحمد بن علي بن عبد القادر (ت845هـ/1441م)، مختصر الكامل في الضعفاء، تح: أيمن ارف الدمشقي، مكتبة السنة، (القاهرة ـ 1994م): ص721.
[402]) تهذيب التهذيب: ج10، ص159.
[403]) يُنظر: ابن غيهب، بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمّد، طبقات النسابين، دار الرشد، (الرياض ـ1987م): ص60.
[404]) تهذيب التهذيب: ج3، ص312ـ313.
[405]) هو علي بن موسى الرضا بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين، من سادات أهل البيت وعقلائهم وجلّة الهاشمين ونبلائهم، استشهد بطوس من شربة سقاه إيّاها المأمون، فمات من ساعته، سنة 203 هـ: ينظر؛ ابن حبان، الثقات: ج8، ص456ـ457.
[406]) يُنظر: التفرشي، مصطفى بن الحسين الحسيني (ت ق 11هـ/ق16م)، نقد الرجال، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، (قم ـ 1418م): ج1، ص288.
[407]) أبو عبيد الله بن محمّد بن عمران (ت384هـ/994م)، الموشح ما أخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر، تح: علي محمّد البجاوي، دار النهضة، (مصر ـ د.ت): ص203.
[408]) يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج15، ص283.
[409]) أبو الحسن علي الشنتريني (ت542هـ/1147م)، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تح: إحسان عباس، دار العربية للكتاب، (تونس ـ 179م): ج7، ص210.
[410]) يُنظر: المقري، شهاب الدين أحمد بن محمّد بن أحمد (ت1041هـ/1631م)، نفح لطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب، تح: إحسان عباس، دار صادر، (بيروت ـ 1997م): ج2، ص511؛ السقاف، حسن بن علي، قاموس شتائم، دار الإمام النووي، (عمان ـ 1999م): ص199.
[411]) يُنظر: القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف، (646هـ/1248م)، إنباه الرواة على أنباء النحاة، المكتبة العنصرية، (بيروت/1424هـ): ج2، ص252.
[412]) تاريخ مدينة بغداد: ج13، ص337.
[413]) المنتظم: ج14، ص185.
[414]) الذهبي، ميزان الإعتدال: ج3، ص151؛ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، تح: عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، (د. م ـ 2002م) ج4، ص221.
[415]) أبو محمّد الحسن بن محمّد، بن هارون، بن إبراهيم، بن عبد الله، بن يزيد، بن حاتم، بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي المهلبي الوزير(291ـ352هـ)؛ كان وزير معز الدولة أبي الحسين أحمد ابن بويه الديلمي ـ المتقدِّم ذكره في حرف الهمزة ـ تولّى وزارته يوم الإثنين لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثلثمائة. وكان من ارتفاع القدر واتساع الصدر، وعلوّ الهمة، وفيض الكف على ما هو مشهور به، وكان غاية في الأدب والمحبة لأهله. وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدّة عظيمة من الضرورة والضائقة... توفي ببغداد، ودُفن في مقابر قريش، في مقبرة النوبختية... يُنظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص124ـ127.
[416]) يُنظر: الصفدي، الوافي بالوفيات: ج12، ص17.
[417]) يُنظر: الأعظمي، وليد، السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني، مطبعة المعروف، ط4، (بغداد ـ 2000م): ص12.
[418]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، المقدِّمة: ص14 ـ 15.
[419]) يُنظر: إسماعيل، عز الدين، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي، دار النهضة العربية، (بيروت ـ 1976م): ص190.
[420]) سيف الدولة الحمداني: علي بن عبد الله، بن حمدان التغلبي، صاحب حلب كان أديباً فيه تشيع، يقال إنّه لم يجتمع قطُّ بباب أحد من الملوك، وما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر؛ ينظر الثعالبي، عبد الملك ابن محمّد ابن إسماعيل (ت429هـ/1038م)، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، تح: مفيد محمّد قميحة، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1983م): ج1، ص37؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج16، ص187.
[421]) يُنظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج3، ص307؛ الحر العاملي، محمّد بن الحسن (ت1104هـ/1692م)، أمل الآمل، تح: أحمد الحسيني، دار الكتاب الإسلامي، (قم ـ د.ت): ج23، ص181؛ الجلالي، محمّد حسين الحسيني، فهرس التراث، تح: محمّد جواد الحسيني، (قم ـ1422هـ): ج1، ص398.
[422]) يُنظر: عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة: ص152ـ153.
[423]) يُنظر: المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص76.
[424]) يُنظر: البيومي، محمّد رجب، حول سكينة بنت الحسين، بحث منشور في مجلة الأزهر، مج 26، (القاهرة ـ 1955م): ص1116؛ زيدان، جرجي، تاريخ التمدن الإسلامي، مطبعة الهلال، ط3، (مصر ـ 1920م): ص90.
[425] صحابي كان من الشجعان الأشداء، أسلم عام الفتح، وكان مع عائشة يوم الجمل وعنده راية قريش وقتل ذلك اليوم... ينظر، ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج 3، ص99.
[426]) لم اعثر على ترجمة وافيه له.
[427]) لم اعثر على ترجمة وافيه له.
[428]) الطبقات الكبرى: ج8، ص347.
[429]) نسب قريش: ص59.
[430]) المحبر: ص438.
[431]) يُنظر: عبد الله القريشي الأسدي (ت 256هـ/869م)، الأخبار الموفقيات، تح: سامي مكي العاني، عالم الكتب، ط2، (بيروت ـ 1996م): ص508.
[432]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، المعارف: ص214؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص294؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج15، ص182؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ج2، ص82.
[433]) الأغاني: ج16، ص158.
[434]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني: ج 16، ص158.
[435]) تذكرة الخواص: ص565.
[436]) يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص460؛ ابن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب: ج2، ص312ـ313.
[437]) يُنظر: الفاكهي، أبو عبد الله محمّد بن إسحاق (ت272هـ/885م)، أخبار مكّة في قديم الدهر وحديثه، تح: عبد الملك عبد الله دهيش، دار خضر، ط2، (بيروت ـ 1414هـ)، ج1، ص140؛ ابن أبي الدّنيا، أبو بكر عبد الله بن محمّد (ت281هـ/894م)، المتمنِّين، تح: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، (بيروت ـ 1997م): ص40؛ اللاكائي، أبو القاسم هبة الله بن الحسن (ت418هـ/1027م)، كرامات الأولياء للالكائي، تح: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طيبة، ط8، (السعودية ـ 2003م): ص150؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج13، ص171؛ ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص135؛ ابن الأبار، محمّد بن عبد الله بن أبي بكر (ت658هـ/1259م)، الحلة السيراء، تح: حسين مؤنس، دار المعارف، ط2، (القاهرة ـ 1985م): ص30.
[438]) يُنظر: ابن الجوزي، صفه الصفوة، : ج1، ص215؛ ابن تيمية، تقي الدين أبو العبّاس (ت728هـ/1326م)، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تح: ربيع بن هادي عمير المدخلي، مكتبة الفرقان، (عجمان ـ 2001م): ص198؛ الذهبي، تاريخ الإسلام: ج5، ص526.
[439]) يُنظر: الكامل في التاريخ: ج3، ص340.
[440]) يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج7، ص230.
[441]) يُنظر: ابن العراقي، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين (ت826هـ/1422م)، المدلِّسين، تح: رفعت فوزي عبد المطّلب ونافد حسين حماد، دار الوفاء، (د. م ـ 1995م): ص52.
[442]) الحسين بن يوسف بن علي (ت726هـ/1325م)، خلاصة الأقوال، المطبعة الحيدرية، ط2، (النجف ـ1281 هـ): ص356.
[443]) يُنظر: ابن عدي، الكامل في الضعفاء: ج5، ص445؛ ابن الكيال، أبو البركات محمّد بن أحمد (ت95 هـ/1543م)، الكواكب النيرات في معرفة من الرواة الثقات، تح: عبد القيوم عبد رب النبي، دار المأمون، (بيروت ـ 1981م): ج1، ص478.
[444]) تهذيب التهذيب: ج5، ص68.
[445]) يُنظر: ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج2، ص250، الحلو، عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة: ص129.
[446]) يُنظر: الذهبي، تاريخ الإسلام: ج5، ص526.
[447]) يُنظر: سكينة بنت الحسين÷: ص80.
[448]) أنس بن زنيم: هجا النبي|، ولما جاء يوم الفتح أسلم فعفى عنه، وكان يحرِّض الناس على علي بن أبي طالب يوم أحد؛ يُنظر: ابن الأثير، أسد الغابة: ج 1، ص259.
[449]) الأغاني: ج3، ص357ـ358.
[450]) يُنظر: المعارف: ص233.
[451]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص159.
[452]) يُنظر: الأغاني: ج19، ص136.
[453]) محمّد الحائري، معالي السبطين في أحوال الحسن والحسين÷، مؤسّسة البلاغ، (بيروت ـ 2011م): ص623.
[454]) يُنظر: حاتم، نوري، الحياة السياسية للإمام السجاد×، مؤسّسة المرتضى العلمية، (بيروت ـ 1994م): ص39.
[455]) يُنظر: الصدوق، معاني الأخبار: ص35؛ المجلسي، بحار الأنوار: ج24، ص12؛ البحراني، هاشم الحسيني (ت1107هـ/1695م)، البرهان في تفسير القرآن، تقديم: محمّد مهدي الآصفي، قسم الدراسات الإسلامية، (قم ـ د.ت): ص114.
[456]) يُنظر: آل سنبل، عارف، عبق من السيرة الحسينية، مؤسّسة طيبة لإحياء التراث، (قم ـ 2009م): ص389.
[457]) محمّد بن أسامة بن زيد تُوفي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان ثقة، قليل الحديث؛ يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص190.
[458]) يُنظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة: ج1، ص357؛ الشعراني، عبد الوهاب بن أحمد بن علي (ت673هـ/1274م)، لوافح الأنوار في طبقات الأخيار، مكتبة محمّد المليجي، (مصر ـ 1315هـ): ج1، ص28.
[459]) يُنظر: ابن الجوزي، صفة الصفوة: ج1، ص357؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج4، ص394.
[460]) يُنظر: عقيل قريش: ص116.
[461]) مروج الذهب: ج3، ص75.
[462]) الضحاك بن فيروز الديلمي، يقال له: الفلسطيني، رواه عن أبيه، وله صحبة، وهو من الطبقة الثالثة؛ يُنظر: الحافظ المزي، تهذيب الكمال: ج13، ص277.
[463]) ابن أعثم الكوفي، الفتوح: ج5، ص155؛ ابن أبي الحديد، عبد الحميد هبة الله بن محمّد بن الحسن (ت656هـ/1258م)، شرح نهج البلاغة، دار إحياء الكتب العربية، ط2، (قم ـ 1967م): ص46، ج20، ص145.
[464]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج2، ص726؛ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك (ت764 هـ/1363م)، الشعور بالعور، تح: عبد الرزاق حسين، دار عمان، (الاردن ـ 1988م): ص249.
[465]) المسعودي، مروج الذهب: ج3، ص76.
[466]) الكامل في التاريخ: ج3، ص318.
[467]) تاريخ اليعقوبي: ج1، ص261.
[468]) يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص517؛ ابن أعثم الكوفي، الفتوح: ج6، ص342؛ القرشي، باقر شريف، حياة الإمام محمّد المهدي× دراسة وتحليل، مطبعة الأمير، (د. م ـ 1996م): ص154.
[469]) يُنظر: ابن عبد البر، العقد الفريد: ج7، ص277؛ ابن قتيبة الدينوري، أبو محمّد عبد الله بن مسلم (ت276هـ/889م)، عيون الأخبار، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1418هـ): ج1، ص311؛ ابن الأبار، محمّد بن عبد الله بن أبي بكر (ت658هـ/1259م)، درر السمط في خير السبط، تح: عز الدين عمر موسى، دار الغرب الإسلامي، (بيروت ـ1407م): ص11.
[470]) يُنظر: الكلتانية: قرية ما بين السوس والصيمرة، وبها قُتل شمر بن ذي الجوشن؛ يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج4، ص476.
[471]) يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص459 ـ460؛ مسكويه، تجارب الأمم: ج3، ص176.
[472]) سراقة بن مرداس البارقي، شاعر عراقي، قدم دمشق في أيام عبد الملك هارباً من المختار الثقفي، وكان هجاه ثمّ رجع إلى العراق مع بشر بن مروان؛ يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج20، ص156.
[473]) يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص461.
[474]) يُنظر: مسكويه، تجارب الأمم: ج6، ص58؛ ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر: ج3، ص34.
[475]) لم أعثر على ترجمة وافية له.
[476]) يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص466؛ ابن كثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص314.
[477]) مروج الذهب: ج3، ص99 ـ100.
[478]) يُنظر: الحلو، عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة: ص114.
[479]) تذكرة الخواص: ص565.
[480]) الأغاني: ج19، ص136.
[481]) الطبقات الكبرى: ج5، ص166.
[482]) يُنظر: اليعقوبي، أحمد بن إسحاق (ت292هـ/904م) تاريخ اليعقوبي، دار صادر، (بيروت ـ د.ت): ج2، ص340؛ الشاكري، حسين، موسوعة المصطفى والعترة ع (الإمام محمّد الباقر)، دار الهادي، (قم ـ1417ه): ج8، ص46.
[483]) لم أعثر على ترجمة وافية له.
[484]) تاريخ اليعقوبي: ج2، ص240.
[485]) يُنظر: العاني، إسراء حسن فاضل، دور المرأة السياسي حتّى نهاية العصر الأموي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 1999م: ص244.
[486]) يُنظر: الحلو، عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة: ص120.
[487]) ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص114.
[488]) ابن عبد ربّه، شهاب الدين أحمد بن محمّد (ت328هـ/939م ـ)، العقد الفريد، دار الكتب العلمية (بيروت ـ 1404هـ): ج3، ص234؛ طبائع النساء وما جاء فيها من عجائب وأخبار وأسرار، مكتبة القرآن، (القاهرة ـ د.ت): ص213.
[489]) يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص140؛ الدارقطني، المؤتلف والمختلف: ج3، ص1476؛ ابن ماكولا، الإكمال في رفع الإرتياب: ج1، ص110.
[490]) يُنظر: هارون، عبد السلام محمّد، نوادر المخطوطات، مكتبة مصطفى الحلبي، ط2، (مصر/1973م): ج1، ص71.
[491]) القيرواني، إبراهيم بن علي بن تميم (ت453هـ/1061م)، زهر الآداب وثمر الألباب، تح: يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1997م): ص242.
[492]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج1، ص204 ـ ص208.
[493]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الاغاني: ج2، ص372.
[494]) الأغاني: ج2، ص375.
[495]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص159.
[496]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، عيون الأخبار: ج4، ص26؛ ابن المعتز، عبد الله بن محمّد (ت296هـ/908م)، البديع في البديع، دار الجيل، (د. ت ـ 1990م): ص164؛ الزمخشري، جار الله (ت583هـ/1143م)، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، مؤسّسة الأعلمي، (بيروت ـ 1412هـ): ج4، ص443؛ ابن منقذ، أسامه بن مرشد بن علي (ت584هـ/1188م)، البديع في نقد الشعر، تح: أحمد بدوي وحامد عبد المحيد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، (د. م ـ د.ت): ص106.
[497]) يُنظر: نسب قريش: ص59.
[498]) يُنظر: النويري، نهاية الإرب في فنون الأدب، : ج4، ص274.
[499]) الأغاني: ج16، ص160.
[500]) يُنظر: ابن الجوزي، المنتظم: ج6، ص9؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج3، ص191.
[501]) يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج29، ص373ـ375.
[502]) يُنظر: الزبير بن بكار، عبد الله القريشي (ت256هـ/869م)، جمهرة نسب قريش وأخبارها، تح: محمود محمّد شاكر، مطبعة المدني، (د. م ـ 1381هـ): ص388ـ389.
[503]) ابن طيفور، أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر، (280 هـ/893م)، بلاغات النساء، صحّحه: أحمد الألفي، (القاهرة ـ 1908م): ص139.
[504]) الكامل في الضعفاء: ج8، ص166ـ167.
[505]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، المعارف: ص214؛ ابن حبيب، المحبر: ص438؛ ابن نشوان، محمّد نشوان بن سعيد (ت573هـ/1177م)، الحور العين، تح: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، (القاهرة ـ 1948م): ص269؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج2، ص29.
[506]) الأغاني: ج16، ص160.
[507]) يُنظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك: ج3، ص664.
[508]) المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار: ج3، ص245.
[509]) يُنظر: سكينة بنت الحسين÷: ص118.
[510]) أبو محمّد علي بن أحمد (ت456هـ/1063م)، رسائل ابن حزم الأندلسي، تح: إحسان عباس، المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، ط2، (بيروت ـ 1987م): ج2، ص108.
[511]) يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص347؛ الزبيري، نسب قريش: ص59؛ ابن حبيب، المحبر: ص438؛ وجدي، محمّد فريد، دائرة المعارف القرن العشرين، دار المعرفة، ط3، (بيروت ـ 1971م)، م: ج 5، ص218.
[512]) الأغاني: ج16، ص164ـ165.
[513]) أشعب بن جبير مولى عبد الله بن الزبير، كنيته أبو العلاء، وكان طماعاً، مزّاحاً، ظريفاً مغنياً، كان صاحب نوادر وملح، توفي سنة 154هـ، يُنظر: المفضل بن سلمة، أبو طالب بن عاصم (ت29. هـ/902م)، الفاخر، تح: عبد العليم الطحاوي، مراجعة: محمّد علي النجار، دار إحياء الكتاب العربي، (د. م ـ1380هـ): ص104؛ ابن ماكولا، الإكمال في رفع الإرتياب: ج1، ص90.
[514]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص167.
[515]) النمارق: هي الوسائد واحدتها نمرقة؛ يُنظر: ابن منظور، لسان العرب: ج10، ص361.
[516]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج19، ص166ـ167.
[517]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج19، ص175ـ177.
[518]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج19، ص177.
[519]) يُنظر: الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة بغداد: ج7، ص501؛ جبور، جبرائيل سليمان، عصر عمر بن أبي ربيعة، المطبعة الكاثوليكية، (بيروت ـ1935م): ج1، ص25.
[520]) محمّد بن شاكر بن أحمد (ت764هـ/1362م)، فوات الوفيات، تح: إحسان عباس، دار صادر، (بيروت ـ 1974م): ج1، ص198.
[521]) يُنظر: الذهبي، ميزان الإعتدال: ج1، ص258.
[522]) يُنظر: السخاوي، محمّد بن عبد الرحمن (ت902هـ/1496م)، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1993م) ج1، ص180.
[523]) يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج9، ص150.
[524]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، المعارف: ص214؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان: ج1، ص294؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج15، ص182.
[525]) يُنظر: العمري، المجدي في أنساب الطالبيين: ص91.
[526]) نهر أبي فطرس: موضع قرب الرملة بأرض فلسطين، كانت به وقعة عبد الله بن علي بن عبد الله بن عبّاس مع بني أمية سنة 132هـ؛ يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج5، ص315
[527]) نسب قريش: ص120.
[528]) يُنظر: باسلوم، مجدي محمّد سرور، وآخرون، موسوعة آل بيت النبي، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1971م): ج2، ص377.
[529]) يُنظر: الزبيري، نسب قريش: ص59.
[530]) يُنظر: ابن حبيب، المحبر: ص438.
[531]) يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص347.
[532]) الأغاني: ج16، ص161.
[533]) المصدر السابق: ص161ـ162.
[534]) هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد، كان من أهل العلم والرواية، ولي المدينة لعبد الملك بن مروان؛ يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص188.
[535]) الأغاني: ج16، ص163.
[536]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص166.
[537]) يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج8، ص347؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص207.
[538]) يُنظر: ابن حبيب، المحبر: ص438.
[539]) يُنظر: الزبيري، نسب قريش: ص59.
[540]) المعارف: ص237 وص594.
[541]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص161.
[542]) يُنظر: الزبيري، نسب قريش: ص59.
[543]) تاريخ الأمم والملوك: ج4، ص111.
[544]) يُنظر: ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص199ـ200؛ الأمين، أعيان الشيعة: ج6، ص432.
[545]) الطبرسي، أبو نصر الحسن بن الفضل (ت548هـ/1153م)، مكارم الأخلاق، منشورات الشريف الرضي، ط6، (د. م ـ 1972م): ص204؛ الحر العاملي، محمّد بن الحسين× (ت1104هـ/ 1692م)، هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، مجمع البحوث الإسلامية، (مشهد ـ 1413هـ): ج7، ص72؛ البهبهاني، محمّد باقر الوحيد (ت1205هـ/1790م)، الرسائل الفقهية، منشورات مؤسّسة العلامة الوحيد البهبهاني، (د. م ـ 1419هـ): ص75.
[546]) يُنظر: ابن حبيب، المحبر: ص438؛ أبو الفرج الأصفهاني، الاغاني: ج16، ص158؛ الطبرسي، إعلام الورى: ج1، ص418؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج5، ص262؛ المقريزي، المواعظ والإعتبار: ج3، ص245؛ الجزائري، نعمة الله (ت1112هـ/1700م)، الأنوار النعمانية، مؤسّسة الأعلمي، (بيروت ـ 1984م): ج1، ص373؛ الأمين، أعيان الشيعة: ج3، ص491؛ بابتي، عزيزة فوال، معجم الشعراء المخضرمين والأمويين، دار صادر، (بيروت ـ 1998م): ص192؛ الدلفي، سطور مع نساء مؤمنات: ص57؛ السامرائي، أحمد عبد الغفور، فقهاء أهل البيت في عصر الخلافة الراشدة والعصر الأموي، مطبعة أنوار دجلة، (بغداد ـ 2006م): ص301.
[547]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين: ص93.
[548]) يُنظر: الخياط، جلال، تاريخ الأدب العربي الحديث، مطبعة الشعب، ط3، (بغداد ـ 1962م): ص42.
[549]) يُنظر: أمين، أحمد، فجر الإسلام يبحث عن الحياة العقلية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية، مكتبة النهضة المصرية، ط9، (د. م ـ 1964م): ص177ـ179؛ النقد الأدبي، دار الكتاب العربي، ط4، (بيروت ـ 1967م): ص451.
[550]) يُنظر: عتيق، عبد العزيز، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، دار النهضة العربية، (بيروت ـ 1974م): ص105.
[551]) يُنظر: الفاخوري، حنا، تاريخ الأدب العربي، دار اليوسف، (بيروت ـ د.ت): ص216.
[552]) يُنظر: زيدان، جرجي، تاريخ آداب اللغة العربية، مكتبة الحياة، (د. م ـ 1992م): ج1، ص261.
[553]) يُنظر: عواضة، رضا ديب، المرأة في شعر (عمر بن ابي ربيعة ـ عمر بن ابي ريشة ـ نزار القباني)، شركة رشاد برس، (بيروت ـ 1999م): ص234.
[554]) ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ج1، ص42؛ الزوزني، حسين بن أحمد بن حسين (ت486هـ/1093م)، شرح المعلقات السبع، دار أحياء التراث العربي، (م ـ 2002م): ص33؛ الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي، (د. م ـ د.ت): ج3، ص130.
[555]) يُنظر: عتيق، تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ص113؛ ملكي، رقية رستم بور، رثاء أهل البيت^ في شعر العصر الأموي، دار الهادي، (د. م ـ 2000م): ص126.
[556]) يُنظر: سلوم، داود، دراسة كتاب الأغاني ومنهج مؤلفه، عالم الكتب، ط3، (بيروت ـ 1985م): ص73ـ74.
[557]) يُنظر: فؤاد، تاريخ التراث العربي، نقله إلى العربية: محمود فهمي حجازي وفهمي أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، (القاهرة ـ 1977م): ج1، ص612ـ615.
[558]) يُنظر: الجمحي، محمّد بن سلام (ت232هـ/846م)، طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محمّد شاكر، د. ط، (القاهرة ـ 1974م): ج1، ص61.
[559]) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، شاعر قريش، كان كثير الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخلاعة، وله في ذلك حكايات مشهورة، وكان فاسقاً تعرّض للنساء في الحجِّ ويشبِّب بهنَّ، كان عبد الملك يمدُّه بالمال كلما مدحَهُ، كان يتغزل في شعره بالثريا ابنة علي بن عبد الله بن الحارث الأموية، تُوفي سنة 93هـ؛ يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج1، ص365؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج5، ص150؛ الصفدي، الوافي بالوفيات: ج22، ص304؛ ابن الغزي، محمّد بن عبد الرحمن (ت1167هـ/1753م)، ديوان الإسلام، تح: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، (بيروت ـ 1990م): ج3، ص276.
[560]) الصُّورين: هو موضع قرب المدينة، قال ابن إسحاق، لما توجّه رسول الله| إلى بني قريظة مرَّ بنفر من أصحابه بالصُّورين قبل أن يصل إلى بني قريظة؛ يُنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان: ج3، ص434.
[561]) الأغاني: ج1، ص171ـ172.
[562]) ميزان الإعتدال: ج3، ص133.
[563]) المصدر السابق: ج4، ص540.
[564]) معجم الأدباء، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، (بيروت ـ 1993م): ج4، ص1487.
[565]) الأغاني: ج1، ص113.
[566]) أمُّها فاطمة بنت عبد الله بن السائب، كانت تجتمع مع عمر بن أبي ربيعه ومعها ابنة أمة المجيد، وجاريتان يغنيان عندهم، يُقال لأحدهما البغوم، والأخرى أسماء؛ يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص139؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج1، ص175.
[567]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج1، ص172.
[568]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج1، ص113.
[569]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج15، ص255؛ عبد الحميد، محمّد محي الدين، شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، دار الأندلس، (بيروت ـ 1997م): ص18.
[570]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج15، ص254.
[571]) أبو الفرج الاصفهاني، الاغاني: ج15، ص255.
[572]) أبو الفرج الأصفهاني، الاغاني: ج17، ص161ـ162.
[573]) توفيق، سكينة بنت الحسين÷، مطبعة التعارف، ط2، (بغداد ـ 1950م): ص21.
[574]) هو إسحق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي، وُلد سنة 150هـ برع في علم الغناء وغلب عليه، تُوفي سنة 235هـ؛ ينظر الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة بغداد: ج7، ص345؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج8، ص165.
[575]) هو أبو جعفر هارون بن المهدي، كان يحب المديح ويجيز الشعراء، ويقول الشعر توفي سنة 193هـ؛ يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج9، ص394.
[576]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج17، ص162ـ163.
[577]) كان يتعرض إلى أُمِّ محمّد بنت مروان بن الحكم، وأمِّ عمر، وبنت مروان بن الحكم؛ يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج1، ص16؛ ج9، ص77.
[578]) يُنظر: البلداوي، سكينة بنت الحسين÷: ص39.
[579]) يُنظر: بيهم، محمّد جميل، المرأة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرأة، دار نشر للجامعيين، (بيروت ـ د.ت): ص26.
[580]) يُنظر: محمّد، سراج الدين، الحكمة في الشعر العربي، دار الراتب الجامعية، (بيروت ـ د.ت): ص26.
[581]) يُنظر: الأعرابي، إبراهيم، ديوان عمر بن أبي ربيعة، مكتبة صادر، (بيروت ـ د.ت): ص6.
[582]) يُنظر: البستاني، بطرس، أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، دار مارون عبود، (د.م ـ د.ت): ص293.
[583]) يُنظر: الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب (ت255هـ/868م)، الحيوان، دار الكتب العلمية، ط2، (بيروت ـ 1424هـ): ج2، ص269.
[584]) العقد الفريد: ج6، ص231.
[585]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج1، ص151.
[586]) عقيلة قريش آمنة بنت الحسين÷ الملقّبة بسكينة: ص54ـ55.
[587]) الشعر والشعراء: ج2، ص540.
[588]) زهر الآداب: ج1، ص101.
[589]) يُنظر: الزجاجي، الأمالي: ص163ـ164؛ القالي، إسماعيل بن القاسم بن عبدرون (ت356هـ/966م)، الأمالي، ترتيب: محمّد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية، ط2، (مصر ـ 1926م): ج2، ص24.
[590]) يُنظر: فضل الله، مريم نور الدين، المرأة في ظل الإسلام، دار الزهراء، (بيروت ـ د.ت): ص320ـ321.
[591]) جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر الشاعر المشهور مدح يزيد بن معاوية، وُلد ومات في اليمامة، وعاش عمره كلّه يناضل شعراء زمنه، تُوفي سنة 110هـ، يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج4، ص590ـ591.
[592]) كثيّر عزّة بن عبد الرحمن بن الأسود، يكنّى أبا صخر، ومعروف ابن أبي جمعة وفد على عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء، وكان من فحول الشعراء، تُوفي سنة 105ـ؛ يُنظر: المرزباني، محمّد بن عمران بن موسى (ت384هـ/994م)، معجم الشعراء، تح: ف. كرنكو، دار الكتب العلمية، ط2، (بيروت ـ 1982م): ص350؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج50، ص76.
[593]) جميل بن عبد الله بن معمر الشاعر الشهير صاحب بثينة، شعره يذوب رقّة أقلّ ما فيه المدح وفد على عبد العزيز بن مروان بقي حدود سنة مائة؛ يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج4، ص385؛ الزركلي، الأعلام: ج2، ص137ـ138.
[594]) نصيب بن رباح مولى عبد العزيز بن مروان، كان فحلا فصيحاً مقدّماً في المدح، تُوفي سنة 108هـ؛ يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج62، ص52ـ53؛ الزركلي، الأعلام: ج8، ص32.
[595]) الأغاني: ج16، ص169ـ170.
[596]) يُنظر: ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج 5، ص182ـ183.
[597] الأحوص: هو عبد الله بن محمّد بن عبد الله، شاعر هجاء، كان معاصراً لجرير، والفرزدق، وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام فأكرمه الوليد، تُوفي في دمشق، ولقِّب بالأحوص لضيق في مؤخرة عينيه.. يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج1، ص509؛ الزركلي، الأعلام: ج4، ص116.
[598]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج1، ص192؛ أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله ابن سهل (ت395هـ/1004م)، الأوائل، دار البشير، (طنطا ـ 1408هـ): ص439.
[599]) يُنظر: المرزباني، الموشح: ص209؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص173.
[600]) يُنظر: المرزباني، الموشح: ص210؛ السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمّد بن علي (ت626هـ/1229م)، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط2، (بيروت ـ 1987م): ص583؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص173.
[601]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج1، ص400؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص173.
[602]) يُنظر: المبرد، أبو العبّاس محمّد بن يزيد (ت285هـ/899م)، الكامل في اللغة والأدب، تح: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط3، (القاهرة ـ1997م): ج1، ص147.
[603]) يُنظر: ابن حمدون، التذكرة الحمدونية: ج7، ص291.
[604]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص172ـ174.
[605]) يُنظر: الموشح: ص218.
[606]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج1، ص480؛ الحموي، أبو بكر بن علي بن عبد الله (ت837هـ/1433م)، طيب المذاق من ثمرات الأوراق، تح: أبو عمار السخاوي، دار الفتح، (الشارقة ـ1997م): ص62؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص170.
[607]) المرزباني، الموشح: ص218.
[608]) يُنظر: الخطيب البغدادي، تاريخ مدينة بغداد: ج4، ص277؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج16، ص448؛ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج5، ص327.
[609]) يُنظر: جعفر بن أحمد الحسين (ت500هـ/1106م)، مصارع العشاق، دار صادر، (بيروت ـ د.ت): ج2، ص80ـ81.
[610]) يُنظر: المرزباني، الموشح: ص220؛ السراج القاري، مصارع العشاق: ج2، ص80؛ ابن الأثير الكاتب، نصر الله بن محمّد بن محمّد بم عبد الكريم (ت637 هـ/1239م)، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار النهضة، (القاهرة ـ د.ت): ج2، ص269.
[611]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج1، ص480؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج1، ص338؛ المرزباني، الموشح: ص151.
[612]) يُنظر: الثعالبي، عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل (ت429هـ/1038م)، ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، دار المعارف، (القاهرة ـ د.ت): ص222؛ أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، 172.
[613]) يُنظر: السراج القاري، مصارع العشاق: ج2، ص81؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص246.
[614]) يُنظر: السراج القاري، مصارع العشاق: ج2، ص82.
[615]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج1، ص480؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج1، ص338.
[616]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج1، ص192؛ ابن سنان الخفاجي، أبو محمّد عبد الله بن محمّد ابن سعيد، (466هـ/1073م)، سرُّ الفصاحة، دار الكتب العلمية، (د. م ـ1982م): ص261؛ السراج القاري، مصارع العشاق: ج2، ص80.
[617]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص171؛ كحالة، عمر رضا، أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام، المطبعة الهاشمية، ط2، (دمشق ـ 1958م): ج2، ص104ـ105.
[618]) تاريخ مدينة دمشق: ج69، ص209.
[619]) يُنظر: المنتظم: ج7، ص178.
[620]) معجم الأدباء: ج6، ص2785.
[621]) يُنظر: الذهبي، سير أعلام النبلاء: ج5، ص590؛ طراد، مجيد، شرح ديوان جرير، دار الفكر العربي، (بيروت ـ 2003م): ص8.
[622]) يُنظر: المرزباني، معجم الشعراء: ص350.
[623]) يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج62، ص52.
[624]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص170.
[625]) النور: آية 31.
[626]) يُنظر: ابن راهوية، مسند إسحاق بن راهوية، (رقم الحديث 1939): ج4، ص160.
[627]) الكامل في اللغة والأدب: ج1، ص148.
[628]) يُنظر: ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج7، ص26؛ المرزباني، الموشح: ص167؛ القرشي، عبّاس بن محمّد بن مسعود (ت1299هـ/1882م)، حماسة القرشي، تح: خير الدين محمود قبلاوي، وزارة الثقافة، (دمشق ـ1995م): ص263.
[629]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج8، ص43.
[630]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص180 ـ181؛ السراج القاري، مصارع العشاق: ج2، ص82.
[631]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص181؛ شيخاني، سمير، نساء، دار الجيل، (بيروت ـ1993م): ج2، ص24.
[632]) مصارع العشاق: ج2، ص83ـ84.
[633]) يُنظر: الأغاني: ج8، ص44.
[634]) يُنظر: القيرواني، زهر الآداب: ج1، ص103؛ الجراوي، أحمد بن عبد السلام (ت609 هـ/1212م)، الحماسة المغربية، تح: محمّد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، (بيروت ـ1991م): ج1، ص171؛ المؤيد، يحيى بن علي بن إبراهيم (ت745 هـ/1344م)، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العنصرية، (بيروت ـ1423م): ج2، ص160.
[635]) يُنظر: المرزباني، أبو عبد الله محمّد بن عمروان (ت384هـ/994م)، مختصر أخبار شعراء الشيعة، تح: محمّد هادي الأميني، (بيروت ـ 1993م): ص64ـ67.
[636]) عروة بن أذينة هو لقب، واسم أذينة يحيى بن مالك، كان شاعراً لبقاً في شعره غزلاً، وكان يصوغ الألحان والغناء على شعره؛ ينظر ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج7، ص18؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج4، ص192.
[637]) يُنظر: ابن قيم الجوزية، محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد (ت751هـ/1350م)، أخبار النساء، منشورات مكتبة التحرير، (د.ت ـ د.م): ص59ـ60.
[638]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج18، ص337؛ ابن حمدون، التذكرة الحمدونية: ج6، ص189.
[639]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء: ج2، ص564ـ565؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد: ج6، ص139؛ البكري، أبو عبيدة عبد الله بن عبد العزيز (ت487هـ/1094م)، التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه، دار الكتب والوثائق القومية، ط2، (القاهرة ـ 2000م): ص26؛ الحريري، القاسم ابن علي بن محمّد (ت516هـ/1122م)، درّة الغواص في أوهام الخواص، تح: مؤسّسة الكتب الثقافية، (بيروت ـ 1998م): ص131؛ الأبشيهي، المستطرف في كلِّ فن مستطرف: ص394.
[640]) ابن طرار، أبو الفرج المعافي بن زكريا (ت390هـ/999م)، الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، تح: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكب العلمية، (بيروت ـ 2005م): ص353؛ ابن سراج القاري، مصارع العشاق: ج2، ص130.
[641]) يُنظر: الاغاني: ج18، ص337ـ338.
[642]) سائب خاثر: هو السائب بن يسار أبو جعفر سُمِّي بخاثر لأنه غنّى صوتاً ثقيلاً، فقالوا: هذا غناء خاثر، كان مولى عبد الله بن جعفر، وكان يخرج به إلى معاوية، فلما سمع صوته قال: قم أقام الله رجليك والله لقد كدت أن أقوم عن وسادتي؛ يُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج2، ص122.
[643]) يُنظر: ضيف، شوقي، الشعر والغناء في المدينة ومكة لعصر بني أمية، دار المعارف، ط3، (مصر ـ د.ت): ص46.
[644]) يُنظر: ضيف، الشعر والغناء: ص48.
[645]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج1، ص199.
[646]) ابن سريج: أبو يحيى مولى بني نوفل بن عبد المناف، من أشهر المغنين في صدر الإسلام من أهل مكّة هو أوّل من ضرب على العود بالغناء العربي، تُوفي في زمن هشام بن عبد الملك سنة 98هـ؛ ينظر النويري، نهاية الارب: ج4، ص25؛ الزركلي، الأعلام: ج4، ص194.
[647]) الغريض: مغني جميل الوجه يجيد ضرب العود والدف ، تُوفي سنة 95هـ؛ يُنظر: الجاحظ، الرسائل الأدبية، دار ومكتبة الهلال، ط2، (بيروت ـ 1423هـ): ص290.
[648]) معبد بن وهب عاش في مطلع دولة بني أمية وأدرك بني العبّاس، كان من كبار المغنين؛ يُنظر: الجاحظ، الرسائل الادبية: ص290.
[649]) حنين: هو حنين بن بلوع الحيري، كان شاعراً ومغنياً عاش مائة سنة وسبع سنين، توفي سنة 110هـ؛ يُنظر: النويري، نهاية الارب: ج4، ص193.
[650]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج2، ص348.
[651]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج2، ص348ـ349.
[652]) يُنظر: نهاية الارب: ج4، ص295.
[653]) يُنظر: الزركلي، الأعلام: ج2، ص287.
[654]) الأغاني: ج1، ص249ـ250.
[655]) يُنظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى: ج5، ص87.
[656]) يُنظر: الجاحظ، الرسائل الأدبية: ص290
[657]) يُنظر: النويري، نهاية الارب: ج4، ص250.
[658]) يثنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج65، ص312.
[659]) أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج17، ص44.
[660]) الأغاني: ج17، ص45ـ47.
[661]) الذهبي، ميزان الإعتدال: ج1، ص550؛ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان: ج2، ص317.
[662]) يُنظر: ابن قتيبة الدينوري، عيون الاخبار: ج4، ص89؛ المبرد، الكامل في اللغة والأدب: ج2، ص193؛ الزجاجي، الأمالي: ص230.
[663]) يُنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج2، ص359 ـ360.
[664]) لقمان: آية 6.
[665]) يُنظر: الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن: ج7، ص310؛ حموش، أبو محمّد مكي بن أبي طالب (ت437هـ/1045م)، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه، إشراف: الشاهد البوشيخي، (الشارقة ـ 2008م): ج9، ص5710.
[666]) الإسراء: آية64.
[667]) يُنظر: الواحدي، الوسيط في تفسير القرآن المجيد: ج3، ص116؛ ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبد الرحمن (ت795هـ/1392م)، روائع التفسير، جمع وترتيب: أبي معاذ صادق بن عوض، دار العاصمة، (السعودية ـ 2001م): ج2، ص80.
[668]) السيوطي، الدر المنثور: ج3، ص179.
[669]) الطيالسي، مسند أبي داود الطيالسي، (رقم الحديث 123): ج2، ص454؛ الطبراني، المعجم الكبير، (رقم الحديث 7803): ج8، ص196.
[670]) الكاشاني، الوافي: ج17، ص217؛ النراقي، أحمد بن محمّد مهدي (ت1245هـ/1829م)، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، (قم ـ 1418هـ): ج14، ص132؛ الشريف الكاشاني، ملا حبيب الله (ت1340هـ/1921م)، ذريعة الإستغناء في تحقيق مسألة الغناء، كتب الإعلام الإسلامي، (قم ـ 1417هـ): ص122.
[671]) الصدوق، أبو جعفر محمّد بن علي (ت318هـ/930م)، الخصال، تعليق: علي أكبر الغفاري، جماعة المدرسين، (قم ـ د.ت): ص24.
[672]) يُنظر: الأغاني: ج4، ص258.
[673]) معاذ الأنصاري: اشتهر بكنيته واختلفوا باسمه اختلافاً كثيراً؛ يُنظر: ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة: ج6، ص114.
[674]) ابن صياد: لم أعثر على ترجمة وافية له.
[675]) العقد الفريد: ج7، ص27.
[676]) الأغاني: ج4، ص231ـ232.
[677]) يُنظر: الأغاني: ج16، ص152؛ ابن الفراء، أبو بكر عتيق الغساني (ت698هـ/1298م)، نزهة الأبصار في فضائل الأنصار، تح: عبد الرزاق بن محمّد، أضواء السلف، (د. م ـ 2004م): ص280؛ البغدادي، عبد القادر بن عمر (ت1093هـ/1682م)، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح: عبد السلام محمّد هارون، مكتبة الخانجي، ط4، (القاهرة ـ 1997م): ج2، ص18؛ فروخ، عمر، تاريخ الآداب العربي، دار العلم للملايين، (بيروت ـ 2006م): ص638.
[678]) يُنظر: الأغاني: ج16، ص152.
[679]) يثنظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني: ج16، ص152ـ153.
[680]) بدراقس لم أعثر على ترجمة له.
[681]) الأغاني: ج16، ص169؛ البستاني، كتاب دارة المعارف: ص694.
(1) يُنظر: الأغاني: ج16، ص151؛ شراد، محمّد، موسوعة نساء شاعرات، تح: حيدر آملي، دار مكتبة الهلال، (بيروت ـ 206م): ص215؛ عطوي، رفيق خليل، صورة المرأة في شعر الغزل الأموي، دار العلم للملايين، (بيروت ـ 1986م): ص221؛ غربال، محمّد شفيق الموسوعة العربية الميسرة، دار النهضة لبنان، (بيروت ـ 1980م): ص993.
[684]) شذرات من فلسفة تاريخ الحسين×: ص150.
[685]) محمّد بن حسين بن عبد الصمد (ت1031هـ/1622م)، الكشكول، تح: محمّد مهدي سيد حسن الخرساني، المطبعة الحيدرية، (النجف ـ 1973م): ص386.