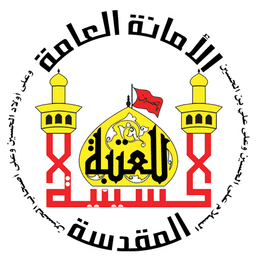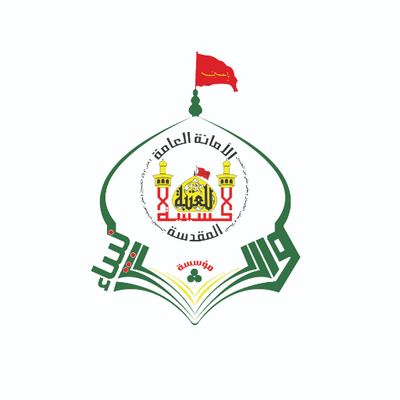المقدّمة
استعرضنا في قسم سابق من هذا المقال ثلاثة من الآثار الوضعيّة التي تترتّب عليها المنفعة والمصلحة لزائري قبر الإمام الحسين×، وفي هذا القسم الثاني سوف نستعرض خمسة آثار أُخرى، لتكون الحصيلة التي تتبّعناها في هذا الصدد ثمانية آثار وضعيّة ذكرتها مجموعة من النصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت^.
إلّا أنّنا نذكّر القارئ الكريم بأنّها ليست حصيلة نهائية تقف عندها بركات زيارة الإمام الحسين×، وإنّما منافع الزيارة الدنيوية والأُخروية شيء كثير لا يمكن حصره في مقال أو كتاب، لكنّا في المقام استعرضنا ما تيسّر لنا استقراؤه من النصوص الكريمة الواردة عن أهل البيت^، والتي تحمل هذا المعنى؛ فإنّ المقال محاولة لتتبّع تلك الآثار المترتّبة على فعل الزيارة من خلال عرض هذه النصوص الشريفة وتحليل المفردات المرتبطة بتلك الآثار.
الأثر الرابع: دفع مدافع السوء
إنّ من جملة الآثار الوضعية المترتّبة على زيارة الإمام الحسين× أنّها تدفع مدافع السوء، وقبل عرض ما ورد فيه هذا المعنى من الروايات الصادرة عن أهل البيت^، لا بدّ من بيان المراد من لفظ السوء ومعناه.
السوء: نعت لكلّ شيء رديء، وهو اسم جامع للآفات والداء[1].
ومن خلال ذلك يُفهم أنّ معنى السوء هو ما يحلّ بالإنسان ممّا يكره حصوله من البلاء أو الآفة، ممّا يُسبّب له الغمّ والضرر والأذى.
وأمّا معنى (المدافع) فقد جاء في (الصحاح) أنّ «المدفع: واحد مدافع، المياه التي تجري فيها»[2]، «ولعلّ المراد الأُمور التي يجري السوء إليها ويستلزمها»[3].
ولقد ذكرت روايات أهل البيت^ أنّ لبعض الممارسات في الدنيا أثراً لصرف السوء ودفعه عن الإنسان، كما في رواية مسعدة بن صدقة، قال: حدّثني جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه: «إنّ رسول الله| قال: إنّ المعروف يمنع مصارع السوء»[4].
وفي لفظ آخر عن الإمام الباقر× أيضاً، قال: «إنّ صنائع المعروف تدفع مصارع السوء»[5].
وبعد هذه التوطئة نتابع الحديث في صلب موضوعنا، وهو وجود النصّ الشريف الوارد عنهم^ في ذكر ترتّب هذا الأثر الوضعي دفع السوء في حياة الزائر؛ بسبب إتيانه قبر الإمام الحسين× وحضور مشهده.
وفي المقام نذكر روايتين تُشيران إلى هذا المعنى:
الرواية الأُولى: ورد عن الإمام أبي جعفر× قوله لمحمّد بن مسلم: «مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين×؛ فإنّ إتيانه يزيد في الرزق، ويمدّ في العمر، ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كلّ مؤمن يقرّ للحسين× بالإمامة من الله»[6].
رتّبت هذه الرواية مجموعة من الآثار الوضعية على زيارة قبر الإمام الحسين× كما تقدّم ومنها أنّها تصرف السوء عن الزائر، فهي صريحة في أنّ البلاء والشدّة وغيرهما من الأذى والشرّ، والآفات التي تحلّ بالإنسان وتنزل به، التي قدّرها الله تعالى وكتبها على عبده، كلّ ذلك يصرفه عنه ببركة زيارته قبر الإمام الحسين×، أو ربّما يبدّل ذلك بالسعادة والسلامة والتوسعة وغيرها من المنافع الدنيوية.
فكان من آثار الزيارة أنّها تقي الزائر من الوقوع في البلاء والمكاره وما يُصيب الإنسان من الآفات الدنيوية، وكما هو واضح أنّ البلاء في الدنيا مختلف الجوانب والأنواع، متفاوت بالنسبة للأفراد والظروف، وهو امتحان ربّاني من الله} عامّ يمتحن به كلّ العباد، فيشمل المؤمن منهم وغيره، فقد امتحن الله تعالى أنبياءه ورفعهم بذلك درجات وأعطاهم ما لم يعطِ لغيرهم.
وفي الوقت الذي يكون البلاء ضرراً ومفسدةً على الإنسان، يُعدّ في الوقت نفسه عاملاً مهمّاً في تقوية العلاقة بين الإنسان وخالقه تعالى؛ لأنّه يُعمّق الارتباط بين العبد وربّه؛ فإنّه كلّما زاد ابتلاء الإنسان توجّه لله} وتضرّع إليه في رفعه عنه، وقد جعل الله تعالى في دفع البلاء والسوء طرقاً مختلفة ومتنوّعة يسلكها العبد في اللجوء إلى الله تعالى للخلاص ممّا حلّ به من بلوى، ومن ذلك زيارة قبر الإمام الحسين×؛ فإنّها باب للنجاة، من خلالها يطلب الزائر مستشفعاً بالحسين× من الله أن يدفع عنه البلاء.
بعض أنواع السوء
بما أنّ السوء اسم جامع للآفات، أو لكلّ ما يحلّ بالإنسان أو يُصيبه فيسبّب له الغمّ، أو هو كلّ ما يقبح، إذاً فهو متكثّر الأنواع، فيكون بالقول من الكلام (قول السوء)، يقول تعالى في كتابه الكريم: (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ)[7].
ويكون بفعل الإنسان (فعل السوء)، كما في قوله تعالى: (يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا)[8]. وقال تعالى أيضاً: (زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ)[9].
ويكون القرين (الصديق) أو الجليس، فقد ورد في النبوي الشريف: «الوحدة خير من قرين السوء»[10]. وفي آخر عنه|: «... جليس السوء»[11].
ويكون في الحوادث والوقائع، كالغرق والهدم والحرق، فعن النبي|: «إنّ الله ليدفع بالصدقة الداء، والدبيلة، والحرق، والغرق، والهدم، والجنون. إلى أن عدّ سبعين نوعاً من السوء»[12].
فما ورد عن الرسول| في هذا الحديث يكشف عن كثرة المفردات التي يصدق عليها مفهوم السوء الذي يُصيب الإنسان.
إنّ كلّ هذه الأنواع يدفعها الله تعالى عن الإنسان الذي يزور قبر الإمام الحسين× كرامةً له؛ فإنّ من ثمرات زيارته× أنّها تُجنّب المستقبل من قول السوء أو فعله، أو مجالسة أصدقاء السوء، وغير ذلك ممّا يصدق عليه أنّه سوء.
ولعلّ الأقرب من هذه الأنواع التي تُشير لها الرواية موضوعة البحث، هو أنّ المقصود بمدافع السوء هو الهدم والغرق والحرق وأكل السبع؛ وذلك أنّ الصدوق في (الفقيه) أورد هذا المعنى في روايته في هذا الباب، فروى عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر محمّد بن علي÷، قال: «مروا شيعتنا بزيارة الحسين بن علي‘؛ فإنّ زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع، وزيارته مفترضة على مَن أقرّ للحسين× بالإمامة من الله}»[13].
فيمكن من خلال المقاربة بين هذه الرواية وبين الرواية موضوعة البحث المتقدّمة الوصول إلى النتيجة المذكورة؛ وذلك اعتماداً على جعل رواية الصدوق الأخيرة مفسِّرةً للأُولى في هذا المقطع «تدفع مدافع السوء» منها خاصّة؛ فإنّه بالإضافة إلى اتّحاد راويهما محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر×، أنّهما تشتركان في كثير من الألفاظ، ولا سيّما في صدر كلّ منهما القائل: «مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين»، ووضوح ما ورد في ذيليهما اللذين يُشيران إلى معنىً واحد أيضاً، وهو أنّ زيارته× مفترضة على مَن أقرّ له بالإمامة.
هذا؛ بالرغم من امتياز الأُولى بذكر ثمرتين أُخريين يترتّبان على فعل الزيارة لم يرد ذكرهما في الثانية؛ فإنّ جميع ذلك يُعتبر بمثابة القرينة على كون المراد بمدافع السوء في الأُولى هو دفع ما ربّما يحلّ بالإنسان من هذه الحوادث الدنيوية التي ذكرتها الرواية الثانية، حيث تقدّم أنّ مفهوم السوء مفهوم واسع وشامل يصدق على الآفات التي يُبتلى بها الإنسان، ومن أبرز مصاديقها هو ما ورد من الهدم والحرق والغرق وغيرها.
ويؤيّد ذلك عنوان الباب الذي أدرج السيّد البروجردي في (جامع أحاديث الشيعة) تحته الروايات التي تذكر فضل زيارة الإمام الحسين×، وفي ضمنها الروايتان المتقدّمتان، فقد قال في عنوان هذا الباب: «باب أنّ زائر الحسين× يُحفظ في نفسه وماله وأهله، ويُبارك له فيهم، ويُمدّ في عمره، ويزيد في رزقه، ويدفع عنه الهدم والغرق والحرق وغيرها من مدافع السوء»[14].فقد عدّ أوّلاً جملة أُمور بارزة تُدفع عن زائر الحسين×، وهي الهدم والغرق والحرق، ثمّ عطف على ذلك: وغيرها من مدافع السوء، وهذا يكشف عن أنّ ما يُفهم من مدافع السوء أوّلاً إذا ذُكرت بهذا اللفظ هو تلك الآفات البارزة منها.
الرواية الثانية: إنّ من الروايات التي يمكن إدراجها تحت هذا الموضوع، ما ورد في (كامل الزيارات) عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر×، قال: «لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين من الفضل لماتوا شوقاً، وتقطّعت أنفسهم عليه حسرات. قلت: وما فيه؟ قال: مَن أتاه تشوّقاً كتب الله له ألف حجّة متقبّلة، وألف عمرة مبرورة، وأجر ألف شهيد من شهداء بدر، وأجر ألف صائم، وثواب ألف صدقة مقبولة، وثواب ألف نسمة أُريد بها وجه الله، ولم يزل محفوظاً سنته من كلّ آفة أهونها الشيطان، ووكّل به ملك كريم يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ومن فوق رأسه ومن تحت قدمه، فإن مات سنته حضرته ملائكة الرحمة، يحضرون غسله وأكفانه والاستغفار له... وينادي منادٍ: هذا من زوّار الحسين شوقاً إليه...»[15].
إنّ الوجه في جعل مضمون هذه الرواية يُفيد الأثر المذكور الذي نحن في صدده، هو أنّ من جملة ما ذُكر في نصّها أنّ الزائر يُحفظ في سنته من كلّ آفةٍ أهونها الشيطان، فقد ورد فيها التعبير بالآفة الذي هو مفهوم عامّ ينطبق على معانٍ كثيرة منها الشيطان، فزيارة الإمام الحسين× تدفع عن الزائر كلّ آفة وتحفظه منها، وأنّ أهون ما تدفعه من الآفات هو الشيطان، وقد تقدّم أنّ السوء هو اسم جامع للآفات التي تحلّ بالإنسان، فهذا المقطع من النصّ الشريف يُفيد أنّ زيارة الإمام الحسين× تدفع عن الزائر كلّ سوء، وتحفظه من الآفات في السنة التي جاء فيها زائراً.
وقد امتاز هذا الحديث الشريف بإشارته إلى خصّيصة من خصائص آداب الزيارة، وهي السلوك الذي يتمتّع به الزائر؛ إذ إنّه متفاوت بين زائر وآخر، والآثار المترتّبة على الزيارة تكون تابعةً لذلك السلوك، وقد ربطت الروايات الشريفة بين ذلك السلوك وما يحصل عليه الزائر من المنافع والفوائد؛ لذلك تكون للزيارة حالات خاصّة تترتّب على أثرها تلك المنافع.
وقد جعل الإمام أبو جعفر الباقر×حصول الأثر في النصّ المتقدّم مترتّباً على سلوك معيّن، وهو إتيان الزائر الحسينَ× وهو في حالة من الشوق؛ فإنّ ذلك من الآداب النابعة من المحبّة والمعرفة بالمزور، فإنّه كلّما ازدادت محبّة المزور في قلب الزائر ونفسه، ازداد اشتياقه لزيارته، فيُقبِل عليه متشوّقاً ومتلهّفاً، وأنّه متى ما كان ذلك الشوق حاصلاً عنده، كشف ذلك عن سرعة حصول أثر الزيارة.
ثم إنّ ذلك الشوق لا ينحصر تحقّقه في خصوص نيّة القدوم للزيارة أو الشروع في السفر إليها، أو حتى عند دخول المشهد المقدّس، وإنّما يستمرّ معه في مدّة زيارته وحتى عند وداعه الإمامَ× والخروج من مشهده، فيزوره ويودّعه وهو في حالة شوق إلى البقاء في الأوّل، وطلب العودة ثانيةً لزيارته في الثاني.
الأثر الخامس: استجابة الدعاء
لعلّ من أهمّ ما يبحث عنه زائر الإمام الحسين×، أو ما يرجوه من الزيارة بعد الأجر والثواب والشفاعة، هو استجابة الدعاء. والدعاء عبارة عن عبادة مهمّة قوامها سؤال العبد من ربّه وطلبه منه، وهو من أفضل العبادات عند الله تعالى.
وأصل الدعاء في اللغة من (دعو)، «وهو أن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك»[16].
وهو عرفاً: «الرغبة إلى الله تعالى فيما عنده من الخير والابتهال إليه بالسؤال»[17]، «وطلب الرحمة منه على وجه الاستكانة والخضوع، وقد يُطلق على التمجيد والتقديس؛ لما فيه من التعرّض للطلب»[18].
وأمّا اصطلاحاً فهو: «طلب الفعل من الأدنى إلى الأعلى، فالدعاء نوع من السؤال»[19]. وحقيقته «استدعاء العبد ربّه جلّ جلاله العناية واستمداده إيّاه المعونة»[20].
واستجابة الدعاء هي تلبية دعوات العباد من قِبل الله تعالى، فهناك آيات صريحة تأمر العباد بالدعاء وتوعدهم باستجابة دعواتهم، فقد قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...)[21]. وقال جلّ وعلا: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)[22].
فالإنسان المسلم يحتاج في حياته إلى الدعاء، وهو جزء لا يتجزّأ منها، ولذلك حفلت السنّة الشريفة بذكر أهمّية الدعاء، حتى جسّدت سيرة الأئمّة المعصومين^ العملية هذا المعنى؛ فإنّ المتأمّل في كتب السِير والحديث والأدعية يجد أنّ لكلّ إمام معصوم مجموعةً من الأدعية، وممّا ورد عنهم^ في أهمّية الدعاء ما عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: «قلت لأبي جعفر×: أيّ العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أفضل عند الله} من أن يُسأل ويُطلب ممّا عنده، وما أحد أبغض إلى الله} ممّن يستكبر عن عبادته ولا يسأل ما عنده»[23].
وقد ورد في نصوص المعصومين^ المتعلّقة بالآداب والسنن أدعية كثيرة تشمل جميع حالات الإنسان، وكذا الأماكن والأزمنة التي يمرّ بها وتمرّ عليه؛ لذلك نراها خصّصت أدعية خاصّة لكلّ آن من آنات الليل والنهار، ولكلّ يوم من أيّام الأسابيع أو الشهور أو السنين أو العمر، وجعلت لكلّ حال من أحوال الإنسان، ولكلّ فعل يُريد القيام به، بل لجميع مطالبه الدنيوية أو الأُخروية، ولكافّة أعماله العادية أو العبادية أو المعاملية، وظائفَ من الدعاء والذكر[24].
خصوصية الدعاء عند مشهد الإمام الحسين×
لم يتحدّد الدعاء بزمان أو مكان خاصّ به، إلّا أنّه وصف بكونه من أفضل العبادات، وكذلك وصفت زيارات مشاهد الأئمّة^ ومراقدهم المقدّسة بكونها من أفضل المقرّبات إلى الله تعالى، فكان الجمع بين الزيارة والدعاء عند أضرحتهم^ يمثّل ارتباطاً روحيّاً وعاطفيّاً بين العبد وربّه من جانب، وبينه وبين الأئمّة المعصومين من جانب آخر.
لذلك ورد في بعض الروايات التأكيد على بعض الأزمنة والأمكنة لاستجابة الدعاء فيها، ومنها: ليلة القدر، وليلة النصف من شعبان، وفي أضرحة الأئمّة المعصومين، وخاصّة تحت قبّة مرقد الإمام الحسين×[25].
ومن الخصوصيّات التي خصّ الله تعالى بها سيّد الشهداء× أنّ الدعاء مستجاب تحت قبّته أو في مشهده، وهو أحد الآثار الوضعية المترتّبة على زيارة قبره× الشريف؛ فإنّه في زيارته من البركات والأسرار المتنوّعة ما تشكّل انعطافات إيجابية ملحوظة في حياة المؤمنين. وفيما يلي عرض لنصوص الروايات الواردة عن أهل البيت^ التي تذكر هذا المعنى:
روايات استجابة الدعاء في مشهده الشريف
الرواية الأُولى: ما في (كفاية الأثر) للشيخ أبي القاسم علي بن محمّد الخزّاز القمّي، مروياً عن عبد الله بن عبّاس، قال: «دخلت على النبيّ| والحسن على عاتقه والحسين على فخذه، يلثمهما ويقبّلهما، ويقول: اللّهمّ، والِ مَن والاهما، وعادِ مَن عاداهما. ثم قال: يابن عبّاس، كأنّي به وقد خُضّبت شيبته من دمه، يدعو فلا يُجاب، ويستنصر فلا يُنصر. قلت: مَن يفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: شرار أُمّتي، ما لهم! لا أنالهم الله شفاعتي. ثمّ قال: يابن عبّاس، مَن زاره عارفاً بحقّه كتب الله له ثواب ألف حجّة، وألف عمرة. ألا ومَن زاره فكأنّما زارني، ومَن زارني فكأنّما زار الله، وحقّ الزائر على الله ألّا يُعذّبه بالنار. ألا وأنّ الإجابة تحت قبّته، والشفاء في تربته، والأئمّة من ولده...»[26].
ورواها الميرزا النوري في (مستدرك الوسائل) عن الفضل بن شاذان في (كتاب الغيبة) عن ابن عبّاس أيضاً[27].
وفي (عدّة الداعي): «فقد روي أنّ الله سبحانه عوّض الحسين× من قتلِه بأربع خصال: جعل الشفاء في تربته، وإجابة الدعاء تحت قبّته، والأئمّة من ذرّيّته، وألاّ يُعدّ أيّام زائريه من أعمارهم»[28].
ويؤيّد ذلك ما أورده ابن المشهدي في (المزار) في زيارة أُخرى يوم عاشوراء، قال: «وممّا خرج من الناحية× إلى أحد الأبواب، قال: تقف عليه (صلّى الله عليه) وتقول: السلام على آدم صفوة الله في خليقته... السلام على مَن جُعل الشفاء في تربته، السلام على مَن الإجابة تحت قبّته...»[29].
الرواية الثانية: روى الشيخ الطوسي في (الأمالي) عن محمّد بن مسلم، قال: «سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّد’ يقولان: إنّ الله تعالى عوّض الحسين× من قتلِه أن جعل الإمامة في ذرّيّته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره»[30].
وكذلك رواها الطبري في (بشارة المصطفى)[31]، والطبرسي في (إعلام الورى)[32].
اشتهر حديث استجابة الدعاء تحت قبّة الإمام الحسين× كثيراً في الأوساط والمحافل الحسينيّة، وتناقلته الألسن ترغيباً وتشويقاً لزيارته× من جانب، وبياناً لفضل تلك الزيارة وما يترتّب عليها من المنافع من جانب آخر. وأصل الحديث كما تقدّم إخبار من النبيّ| بمقتل الحسين×، وهو من إخباراته| الغيبية الكثيرة التي تُنبئ عن علمه بالحدث قبل وقوعه.
وقد عرضت هاتان الروايتان الفضائل والكرامات الخاصّة بسيّد الشهداء×، وذلك عوضاً له عن قتلِه، فقد خصّه الله تعالى بخصال كانت واحدة منها أنّ استجابة الدعاء تحت قبّته أو عند قبره، وهذا في الوقت الذي يكشف عن فضل زيارته يُعطي للزائر حافزاً كبيراً يدعوه إلى الإقدام إلى زيارته والإسراع فيها.
هذا؛ وقد تضمّنت الرواية الأُولى بالإضافة إلى بيان هذه الخصوصيّة مجموعة أُمور مهمّة يجدر الإشارة إليها في نقاط:
النقطة الأُولى: إشارة النبيّ| إلى ولاية الإمامين الحسنين÷.
النقطة الثانية: الإخبار بمقتل الإمام الحسين× وأنّ شيبته الكريمة تُخضّب من دمه، الأمر الذي يُفصح عن بشاعة ذلك الحدث وغرابته. وكذا الإشارة إلى مظلوميّة الإمام الحسين×، وأنّه يطلب النصرة فلا يُنصر.
النقطة الثالثة: إنّ مرتكبي هذه الجريمة النكراء هم شرار الأُمّة.
النقطة الرابعة: إنّهم محرومون من شفاعة نبيّ الأُمّة يوم القيامة.
النقطة الخامسة: عرفان الزائر بحقّ المزور، أي: المعرفة التامّة بأنّه إمام مفترض الطاعة، وقد تقدّم الكلام في هذا الشأن في الأثر الأوّل (زيادة الرزق).
النقطة السادسة: ذكر الأجر والثواب المترتّب على زيارته، وغاية ذلك عدم عذاب الزائر بالنار.
النقطة السابعة: بيان الخصوصيّات التي امتاز بها الإمام الحسين× إكراماً له من الله سبحانه وتعالى، ومنها أنّ الدعاء مستجاب تحت قبّته.
نعم، نصّت هذه الرواية على أنّها ثلاث خصوصيّات: إجابة الدعاء تحت قبّته×، والشفاء في تربته، وأنّ الأئمّة^ من ولده. بينما جعلها في (عدّة الداعي) أربع خصوصيّات زيد على المذكورات بأنّ أيّام زائريه× لا تُعدّ من أعمارهم، وهذا الأخير من الآثار الوضعية المترتّبة على الزيارة أيضاً، وقد تقدّم بحثه في الأثر الثاني (المدّ في العمر).
هذا من جانب، ومن جانب آخر تفاوت اللفظ في هذه الخصوصيّة بين (تحت قبّته) كما في الرواية الأُولى، و(عند قبره) كما في الرواية الثانية، وهنا لا بدّ من وقفة قصيرة نستوضح من خلالها المقصود من القبّة وما هو معناها، لكي يتسنّى لنا إحراز وتحديد الموضع الذي هو محطّ نظر استجابة الدعاء.
مفهوم القبّة
إنّ للتطوّر الحياتي وتسابق الزمن دوراً كبيراً في تغيير أشكال وصفات البناء والعمران في المدن والقرى، وربّما يتبع ذلك أحياناً التغيير في المصطلح أيضاً، لكنّ الوظائف والمهامّ التي تحويها تلك المصطلحات تبقى ثابتة؛ من هنا صار يختلف مصطلح القبّة المعاصر من ناحية البناء والشكل عمّا هو عليه في الزمن السابق، لذا فإنّ مصطلح القبّة صار يُطلق على معانٍ، وهي بالرغم من كثرتها إلاّ أنّ وظيفتها واحدة.
فهي في المصطلح المعاصر عبارة عن بناء نصف كروي مجوّف يقف على أعمدة أو جدران، يُستخدم لتسقيف المساجد والجوامع وغيرها كالجامعات والبنايات الكبيرة، وتُعتبر عنصراً من عناصر العمارة الإسلاميّة[33].
بينما هي في المصطلح القديم تحمل عدّة معانٍ:
1ـ البناء من شعر ونحوه، و«في الحديث: كان إذا أحرم أبو جعفر× أمر بقلع القبّة والحاجبين... والمراد بها هاهنا قبّة الهودج، وبالحاجبين السترين المغطّى بهما»[34].
والبناء هنا أعمّ من كونه من الشعر أو الآجر أو اللبن، وكذلك هو أعمّ من كونه على الأرض أو غيرها كما يُشير إليه حديث أبي جعفر× المتقدّم.
2ـ وفي (تاج العروس): «والقبّة من البناء معروفة، وقيل: هي البناء من الآدم خاصّةً مشتقّ من ذلك... وفي العناية: ما يُرفع للدخول فيه ولا يختصّ بالبناء»[35].
3ـ قال ابن الأثير: «القبّة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب»[36].
4ـ إنّها بمعنى الحجرة أي الغرفة وهو البناء المعروف المعاصر، وهو ما ورد في بعض الأحاديث الشريفة، ففي (أمالي) الصدوق: «عن أبي الصلت الهروي، قال: بينا أنا واقف بين يدي أبي الحسن عليّ بن موسى الرضا× إذ قال لي: يا أبا الصلت، ادخل هذه القبّة التي فيها قبر هارون فأتني بتراب من أربع جوانبها»[37].
وممّا تقدّم من معانٍ لمصطلح القبّة يمكن القول بأنّها بناء يكون فوق القبر أو حوله مرتفع عليه، ويمكن الدخول تحته أو فيه، دون أن يختصّ بشكل هندسي معيّن، ودون أن يتكوّن من مادّة معيّنة كالآجر مثلاً؛ فإنّ كلّ بناء يُرفع فوق القبر أو غيره، ويمكن للزائر أو الداخل الوقوف أو المكوث تحته يمكن تسميّته بالقبّة.
ومن هنا؛ نستطيع القول بأنّ هذا البناء يمكن أن يكون صغيراً وكذلك يكون كبيراً موسّعاً؛ وذلك حسب التطوّر العمراني الذي يطرأ على المرقد الشريف، والقبّة إنّما تُشير إلى رمزيّة ما يُرفع من البناء فوق القبر الشريف، الأمر الذي يُفهم منه أنّه ليس شرطاً أن تكون استجابة الدعاء منوطةً بصدور الدعاء من تحت القبّة المعروفة اليوم، التي تعلو قبر الإمام× الشريف، ولا سيّما بأنّ جملة (تحت قبّته) مطلقة لم تُحدّد شكل هذه القبّة أو قطرها وحجمها لكي يتعيّن الوقوف تحتها وصدور الدعاء من هذا المكان تحديداً؛ وعليه يكون المراد من ذلك أنّ الدعاء مستجاب عند قبره الشريف دون تقييده بتحتية القبّة، وذلك في كلّ عصر وزمان، وسواء كانت القبّة موجودةً أم غير موجودة، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة.
وهذا ما يؤيّده لسان الرواية الثانية التي ورد فيها لفظ: (وإجابة الدعاء عند قبره)، فإنّها لم تحدّد موضع استجابة الدعاء عند قبره بكونه تحت القبّة الشريفة، الأمر الذي يدلّ على أنّ ذكرها في الرواية الأُولى من باب الرمزيّة والإشارة للبناء أو السقف الذي يعلو المرقد الشريف.
وسوف يأتي لاحقاً من الروايات الشريفة ما يُشير إلى هذا المعنى أيضاً.
الرواية الثالثة: ما رواه في (كامل الزيارات) «عن أبي هاشم الجعفري، قال: بعث إليّ أبو الحسن× في مرضه وإلى محمّد بن حمزة، فسبقني إليه محمّد بن حمزة، فأخبرني أنّه ما زال يقول: ابعثوا إلى الحائر. فقلت لمحمّد: ألا قلت له: أنا أذهب إلى الحائر. ثمّ دخلت عليه فقلت له: جُعلت فداك، أنا أذهب إلى الحائر. فقال: انظروا في ذلك... إلى أن قال: فذكرت ذلك لعلّي بن بلال، فقال: ما كان يصنع بالحائر وهو الحائر؟! فقدمت العسكر فدخلت عليه، فقال لي: اجلس حين أردت القيام، فلمّا رأيته أنس بي ذكرت قول علي بن بلال. فقال لي: ألا قلت له: إنّ رسول الله| كان يطوف بالبيت ويقبّل الحجر، وحرمة النبيّ| والمؤمن أعظم من حرمة البيت، وأمره الله أن يقف بعرفة. إنّما هي مواطن يُحبّ الله أن يُذكر فيها، فأنا أُحبّ أن يُدعا لي حيث يُحبّ الله أن يُدعا فيها، والحائر من تلك المواضع»[38].
ورواها الشيخ الكليني في (الكافي)[39]، ونقلها الحرّ العاملي في (وسائل الشيعة)[40] عنه، والنوري في (مستدرك الوسائل)[41] عن (كامل الزيارات).
تُشير الرواية إلى أنّ إحدى ثمرات زيارة قبر الإمام الحسين× هي استجابة الدعاء؛ لذلك طلب الإمام الهادي× أن يُدعا له في ذلك الموضع المقدّس، وقد شدّد× الطلبَ في ذلك وأوضح لأصحابه السبب؛ وذلك لما لإتيان قبر الإمام الحسين× ومشهده من الأهمّية في الدعاء واستجابته؛ فإنّ الظاهر من الرواية أنّه× قد طلب أن يبعثوا رجلاً إلى حائر الإمام الحسين× يدعو له، ويسأل الله تعالى الشفاء للإمام× عنده، وهذا إنّما يدلّ على أنّ الدعاء عند قبره× مستجاب.
وقد تضمّنت الرواية بالإضافة إلى ذلك مجموعة أُمور أُخرى أيضاً، يمكن إجمالها فيما يلي:
أوّلاً: يظهر من لسان الرواية أنّها صدرت في حال كان الإمام× وأصحابه يعيشون ظروف التقيّة خوفاً من السلطة الحاكمة آنذاك؛ فإنّ جملة: (انظروا في ذلك) معناها تفكّروا وتدبّروا فيه بأن يقع على وجه لا يطّلع عليه أحد.
ثانياً: التأكيد على زيارة مشهد الإمام الحسين× وعدم ترك هذا الأمر، وأنّه في حال عدم مكنة الإنسان من الزيارة بنفسه لحصول العائق والمانع من ذلك يمكنه إرسال مَن يزور عنه وينوب عنه في الزيارة، وكلّ ذلك حفاظاً على إحياء هذه الشعيرة المقدّسة وعدم تركها أو إهمالها؛ لما فيها من الميزات والمنافع الدنيوية والأُخروية.
ثالثاً: إنّ المقصود من الحائر هو حائر الإمام الحسين×، أي: موضع قبره الشريف[42].
رابعاً: أهمّية الدعاء في حياة المؤمن، وذلك لا يقتصر على دعاء الإنسان لنفسه فقط، وإنّما أشارت الرواية إلى أهمّية دعاء المؤمن للمؤمن وإن لم يكن بينهما أيّة صلة؛ فإنّه× قال لأصحابه: «ابعثوا إلى الحائر»، أي: ابعثوا برجل دون تسميته أو تحديد هويّته، والمقصود من ذلك إرسال رجل من المؤمنين يدعو للإمام× في الحائر الحسيني.
خامساً: تُفصح الرواية عن عقيدة الولاء التي يتمتّع بها أصحاب الإمام الهادي× واعتقادهم بأنّ نور الأئمّة^ جميعاً هو نور واحد، وأنّ ما يتمتّع به المعصومون^ من ميزات هي مشتركة بينهم جميعاً.
سادساً: الإشارة إلى أنّ المسبّبات تقع بأسبابها، وأنّ بعض المواطن الشريفة هي سبب لاستجابة الدعاء، ومنها حائر الإمام الحسين×؛ لذلك كان الإمام الهادي× يُحبّ أن يُدعا له بهذا الموضع.
سابعاً: بيان حرمة المؤمن وأنّها أعظم من حرمة الكعبة المشرّفة. وإلى هذا المعنى أشارت روايات كثيرة، منها: ما عن أبي عبد الله× قال: «المؤمن أعظم حرمةً من الكعبة»[43].
هذا؛ وقد نسب ابن فهد الحلّي في (عدّة الداعي) مثل هذه القصّة إلى الإمام الصادق×[44].
وكيف كان، فسواء كانت الحادثة قد رويت عن الإمام الصادق×، أم عن الإمام الهادي×؛ فإنّ المضمون فيها واحد وإن بعدت المسافة الزمنيّة بين عصريهما÷، وهو الإشارة إلى كون قبر الإمام الحسين× من مواطن ومواضع استجابة الدعاء.
الرواية الرابعة: ما رواه الصدوق: «عن بشير الدهان، عن أبي عبد الله×، قال: إنّ الرجل ليخرج إلى قبر الحسين×، فله إذا خرج من أهله بأوّل خطوة مغفرة لذنوبه، ثمّ لم يزل يقدّس بكلّ خطوة حتى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه الله فقال: عبدي سلني أعطِك، ادعني أجبك، اطلب منّي أعطِك، سلني حاجتك أقضها لك. قال: قال أبو عبد الله×: وحقّ على الله أن يُعطي ما بذل»[45].
رافقت هذه الرواية زائر الإمام الحسين× من أوّل خروجه من أهله، فأغدقت عليه بأوّل خطوة يخطوها باتّجاه مشهد الإمام الحسين× أن بشّرته بغفران الذنوب، ثم لا زالت تواكبه حتى يأتي القبر الشريف، فعندها تبدأ المخاطبة والمناجاة بين العبد الزائر وربّه تعالى، فيفتح الله تعالى أبواب رحمته أمام عبده إكراماً لصاحب القبر المزور×.
إنّ من ميزات هذه الرواية في الدلالة على إثبات المفردة موضوعة البحث استجابة الدعاء أنّها جعلت الخطاب موجّهاً من الله سبحانه وتعالى إلى العبد مباشرةً، وكأنّ الباري تعالى أراد أن يُشعر الزائر وهو في مشهد الإمام الحسين× بأنّه قد دخل بيتاً من بيوت الرحمن، فأصبح ضيفاً عليه، يُلبّي له حاجته، ويوفّر له جميع ما يلزمه.
لقد اشتملت الرواية على أربع جُمل تُفيد معنى استجابة الدعاء، إحداها قد أفادت هذا المعنى صراحةً، وهي قوله: (ادعني أجبك)، بمعنى أنّ الدعاء عند قبر الإمام الحسين× مستجاب؛ لأنّ لفظ (أجبك) من الإجابة، وهي بمعنى سماع الطلب والردّ عليه، والله تعالى هو المجيب، أي يستجيب الدعاء من أوليائه، قال تعالى: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ...)[46]، فمعنى أجاب الله دعاءه: أي قَبِله[47].
أمّا الجمل الثلاث الأُخرى فإنّها قد أفادت معنى الإجابة لا بالتصريح كما في الجملة المتقدّمة؛ لأنّها قد عبّرت عن الدعاء بالسؤال تارةً، وبالطلب أُخرى، وعن الإجابة بالعطاء أحياناً، وقضاء الحاجة أحياناً أُخرى. ولا يخفى بأنّ السؤال والطلب هو معنى الدعاء، وأنّ العطاء أو قضاء الحاجة هو معنى إجابة هذا الطلب والسؤال، فهو استجابة الدعاء.
ثم يؤكّد الإمام الصادق× في الجملة الأخيرة في الرواية على استجابة الدعاء بقوله: «وحقّ على الله أن يُعطي ما بذل»؛ فإنّ الجملة مطلقة أطلقها الإمام تعقيباً على الجُمل الأربع التي ذكرها في المناجاة والمخاطبة التي تضمّنت معنى الدعاء والاستجابة؛ فإنّه حقّ على الله أن يُعطي للعبد ما وعد به في قوله: (أجبك) أو: (أعطك)، وإجابة دعائه هو عطاء له بما تمنّاه على ربّه ودعاه به.
الرواية الخامسة: ما رواه ابن قولويه في (كامل الزيارات): «عن شعيب العقرقوفي، عن أبي عبد الله×، قال: قلت له: مَن أتى قبر الحسين× ما له من الثواب والأجر جُعلت فداك؟ قال: يا شعيب، ما صلّى عنده أحد الصلاة إلّا قبلها الله منه، ولا دعا أحد عنده دعوةً إلّا استجيبت له عاجلةً وآجلةً. فقلت: جُعلت فداك، زدني فيه. فقال: يا شعيب، أيسر ما يُقال لزائر الحسين بن علي×: قد غفر لك يا عبد الله، فاستأنف عملاً جديداً»[48].
ورواها الشيخ المفيد[49] وابن المشهدي[50] في مزاريهما أيضاً.
هذه الرواية واحدة من فيض من الروايات التي وردت في ذكر فضل زيارة الإمام الحسين× وما يترتّب عليها من الأثر الذي يصبّ بصالح الزائر، وقد عبّرت عن الزيارة بإتيان القبر الشريف، وذكرت ما لهذا الإتيان من الأجر والثواب بأنّ الصلاة عنده مقبولة عند الله تعالى، وأنّ الدعاء في ذلك المشهد المقدّس مستجاب، وأنّ أيسر ما تحقّقه هذه الزيارة غفران الذنوب.
إنّ من جملة الآثار الوضعية التي تُثبتها هذه الرواية على إتيان قبر الإمام الحسين× هي استجابة الدعاء، وكأنّ لسان الرواية في هذا المقطع منها ينفي عدم استجابة الدعاء عنده؛ فإنّها قرّرت: (ولا دعا عنده أحد إلّا استجيب له...)، بمعنى حتميّة استجابة الدعاء في هذا المكان المقدّس؛ لأنّ أُسلوبها من باب أُسلوب قصر الموصوف على الصفة، وهو في علم البلاغة أن يُحبس الموصوف على الصفة ويختصّ بها، فقد قصرت الجملةُ الدعاءَ الذي هو موصوف بالصفة التي هي الاستجابة، ونفت عنه الصفة الأُخرى وهي عدم الاستجابة، فيكشف ذلك عن أنّ دعوة الزائر في مشهد الإمام الحسين× مستجابة.
وقد وصفت الرواية أيضاً استجابة الدعاء إمّا بالعاجلة وإمّا بالآجلة، والأُولى تُشير إلى تحقّق ما دعا به الزائر وحصوله له في دار الدنيا، وهي معنى حصول الأثر الوضعي واستجابة الدعاء. والثانية يُحتمل فيها أن يكون حصول الاستجابة متأخّراً بعده بمدّة، وكذلك يُحتمل فيها أن تكون استجابة أُخروية في دار الآخرة، فإنّه ينال العبد بالدعاء ما عند الله تعالى من المغفرة وغفران الذنوب والخلاص من العذاب ودخول الجنّة، وفي ذلك يقول الإمام الصادق×: «أكثروا أن تدعوا الله؛ فإنّ الله يُحبّ من عباده المؤمنين أن يدعوه، وقد وعد عباده المؤمنين الاستجابة، والله مصيّر دعاء المؤمنين يوم القيامة لهم عملاً يزيدهم في الخير»[51].
لذا؛ إذا تأخّرت الاستجابة فلمصالح تخصّ العبد لا يعلمها إلّا عالم الغيوب، فعلى الداعي ألّا يقنط من رحمة ربّه ولا يستبطئ الإجابة.
الرواية السادسة: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر×: قال: «إنّ الحسين صاحب كربلاء قُتل مظلوماً مكروباً عطشاناً لهفاناً، وحقّ على الله} ألاّ يأتيه لهفان ولا مكروب ولا مذنب ولا مغموم ولا عطشان ولا ذو عاهة ثم دعا عنده وتقرّب بالحسين× إلى الله عزّ وجل، إلاّ نفّس كربته، وأعطاه مسألته، وغفر ذنبه، ومدّ في عمره، وبسط في رزقه، فاعتبروا يا أُولي الأبصار»[52].
إنّ استجابة الدعاء لا تقتصر على لفظ الدعاء مجرّداً عن العوامل الأُخرى المؤثّرة في الاستجابة، التي من أهمّها الزمان والمكان، فهناك من الآداب الزمانية والمكانية ما ترافق لفظ الدعاء وتكون سبباً في استجابته، وكذا تكون من العوامل المؤثّرة في سرعة الاستجابة، ومن تلك الشروط والآداب المكانية اختيار مشهد الإمام الحسين× ليكون هو محلّ الدعاء؛ وذلك لما لهذه البقعة الطاهرة من فضل وخصوصية أشارت لها هذه الرواية، وهي أنّ صاحبها قد ضحّى بنفسه وعياله وأهل بيته، فقُتل مظلوماً عطشاناً مكروباً لهفاناً من أجل الإسلام وإصلاح أُمّة جدّه الرسول المصطفى|.
لذا؛ حثّت الرواية على إتيانه وزيارته، ورتّبت أثراً وضعياً ينال الزائر ثمرته، وهو استجابة الدعاء، فقالت: «ثمّ دعا وتقرّب بالحسين»، ونتيجة ذلك:«وأعطاه مسألته»، بمعنى أنّه تعالى قد استجاب دعاءه وحقّق له مطلبه ومسألته، وهذا ممّا يزيد في سعادة الإنسان أن يرى الآثار المترتّبة على عمله، فيحسّ بعناية الله تعالى له، وقوّة ارتباطه مع ربّه ومع صاحب المشهد الذي حضر لزيارته وتقرّب به إلى الله.
الأثر السادس: عيادة الملائكة زائر الإمام الحسين×
عيادة المريض مأخوذة من العود أو العوادة، قال الزبيدي: «وقال اللحياني: العوادة من عيادة المريض... وكلّ مَن أتاك مرّةً بعد أُخرى عائد وإن اشتهر ذلك في عيادة المريض حتّى صار كأنّه مختصّ به»[53].
فالعيادة هي زيارة مَن أصابه مرض أو ضعف أخرجه عن حال الصحّة، وهي من الآداب الإسلاميّة الرفيعة التي حثّ الإسلام عليها، مؤكّداً على زيارة المرء لأخيه المسلم في حال إصابته بعلّة أو ضعف يُخرجه عن حدّ الاعتدال، سواء كان ذلك المرض شديداً يمنع صاحبه عن الخروج إلى الناس، أم لم يقعده؛ إذ إنّ الإسلام قد اعتبر هذه الزيارة في تلك الظروف من المستحبّات المؤكّدة، قال السيّد اليزدي في (العروة الوثقى): «عيادة المريض من المستحبّات المؤكّدة، وفي بعض الأخبار أنّ عيادته عيادة الله تعالى؛ فإنّه حاضر عند المريض المؤمن»[54].
وليس مثل هذه الزيارة منحصر بين الإنسان وأخيه الإنسان الآخر، وإنّما هناك زيارة بهذا العنوان تحصل من قِبل الملائكة يزورون فيها الإنسان أثناء إصابته بالمرض، وذلك في حال زيارته قبر الإمام الحسين×، فإنّ واحداً من الآثار الوضعية المترتّبة على زيارة الإمام الحسين× هو العود على الزائر بزيارته أيضاً، لكنّ هذه الزيارة يُحقّقها الملائكة الحافّون بقبر الإمام الحسين× في حال مرض الزائر.
وهذا ما يُستفاد من جملة من الروايات الواردة في فضل زيارة الإمام الحسين×، وهي فيما يخصّ المقام كالتالي:
الرواية الأُولى: «عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد الله×، قال: سمعته يقول: زوروا الحسين× ولو كلّ سنة؛ فإنّ كلّ مَن أتاه عارفاً بحقّه غير جاحد لم يكن له عوض غير الجنّة، ورُزِق رزقاً واسعاً، وأتاه الله بفرج عاجل. إنّ الله وكّل بقبر الحسين بن علي× أربعة آلاف مَلَك، كلّهم يبكونه ويشيّعون مَن زاره إلى أهله، فإن مرض عادوه، وإن مات شهدوا جنازته بالاستغفار له والترحّم عليه»[55].
الرواية الثانية: «عن هارون بن خارجة، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: وكّل الله بقبر الحسين× أربعة آلاف مَلَك، شعث غبر، يبكونه إلى يوم القيامة، فمَن زاره عارفاً بحقّه شيّعوه حتّى يبلغوه مأمنه، وإن مرض عادوه غدوةً وعشيةً، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة»[56].
الرواية الثالثة: ما ورد في (كامل الزيارات) «عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله×، قال: كأنّي بالقائم× على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله|... فينحط عليه ثلاثة عشر آلاف مَلَك، وثلاثمئة وثلاثة عشر مَلَكاً. قلت: كلّ هؤلاء الملائكة؟! قال: نعم... أربعة آلاف مَلَك هبطوا يُريدون القتال مع الحسين× فلم يُؤذن لهم في القتال، فهم عنده شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة، ورئيسهم مَلَك يقال له: منصور، فلا يزوره زائر إلاّ استقبلوه، ولا يودّعه مودّع إلاّ شيّعوه، ولا يمرض مريض إلّا عادوه، ولا يموت ميّت إلّا صلّوا على جنازته، واستغفروا له بعد موته، وكلّ هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم× إلى وقت خروجه»[57].
الرواية الرابعة: «عن أبي الصباح الكناني، قال: سمعت أبا عبد الله× يقول: إنّ إلى جانبكم قبراً ما أتاه مكروب إلّا نفّس الله كربته، وقضى حاجته، وإنّ عنده أربعة آلاف مَلَك منذ قُبض، شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فمَن زاره شيّعوه إلى مأمنه، وإن مرض عادوه، ومَن مات اتّبعوا جنازته»[58].
تعرّضت هذه الروايات لذكر أمرين مهمّين، وهما:
الأوّل: إنّها بأجمعها ذكرت أنّ عدد الملائكة عند قبر الإمام الحسين× هو أربعة آلاف مَلَك.
الثاني: هناك وظائف ومهامّ يُمارسها هؤلاء الملائكة، وهي على قسمين:
أوّلهما: البكاء على الإمام الحسين×، وهذا البكاء يستمرّ ويدوم إلى يوم القيامة، كما نصّ عليه أكثر الروايات المتقدّمة. وقد وصف بعضُ هذه الروايات الملائكةَ بأنّهم شعث غبر، والأشعث هو مَن تغبّر شعر رأسه بافتقاده تنسيقه[59]، أي: علته الغبرة، فهو غير مرتّب ولا مرجّل. والأغبر هو من تغيّر وجهه[60]. وهذا كان يقال كثيراً في القدَم لمـَن يقدم من سفر، فإنّه ومن عناء السفر وصعوبة الطريق كان الغبار يعلو شعور المسافرين ووجوههم فتتغيّر.
وقد كان هذا حال الملائكة الذين نزلوا محدقين بقبر الإمام الحسين×، وكأنّهم قادمين من سفر، فإنّهم شعث غبر حزناً على صاحب القبر الشريف.
ثانيهما: وظائف يُمارسها الملائكة تعود بالنفع لزائر الإمام الحسين×، وهي:
الوظيفة الأُولى: تشييع زائر الإمام الحسين×، ومعنى ذلك: خروج الملائكة مع الزائر عند رحيله إكراماً له وتوديعاً؛ فإنّ زائر الإمام الحسين× ضيفاً على صاحب القبر، فيخرج الملائكة الموكّلون به لتشييع الزائر، حتّى أنّهم يُبالغون في ذلك إلى أن يبلغ أهله أو مأمنه.
الوظيفة الثانية: شهود جنازة الزائر بعد موته، بمعنى حضورهم جنازته واتّباعه إلى حيث مدفنه، وقد زادت الرواية الثالثة شيئاً آخر، وهو الصلاة على الجنازة.
الوظيفة الثالثة: انتظار قيام القائم× إلى وقت خروجه، وهذا يُشعر بأنّهم يقومون مع القائم ويثورون معه طلباً للثأر. وهذا ما انفردت بذكره الرواية الثالثة؛ فإنّها ذكرت في طيّاتها أنّ هؤلاء الملائكة هبطوا عازمين على القتال مع الإمام الحسين× نصرةً له، لكن لم يؤذَن لهم في ذلك، فما جاء في ذيل الرواية من أنّهم ينتظرون القائم يُشعر بأنّهم يطلبون بثأر الإمام الحسين×؛ لكونهم لم يستطيعوا نصرته والقتال بين يديه وتحت رأيته في وقعة كربلاء، فعلّق نصرهم له حتّى خروج القائم×.
الوظيفة الرابعة: عيادة الزائر إذا مرض، وهي المفردة موضوعة البحث، فإنّها من الآثار الوضعية المترتّبة على زيارته الإمام الحسين×، والعيادة كما تقدّم من الآداب الإسلاميّة الرفيعة. والذي يُفهم من عيادة الملائكة للزائر المريض أنّها نوع تكريم واحتفاء واهتمام به؛ إذ عندما يحسّ المريض أو يشعر وليس شرطاً أن يكون شعوراً مادّياً ولو معنوياً بأنّ هناك مَن يهتمّ به ويقف معه وإلى جانبه في حالة ضعفه، ويكرمه بحضوره عنده، لا بدّ أن تعتريه نوبة الاطمئنان والاستقرار، وهذه بدورها تُساعده على التماثل إلى الشفاء.
فعيادة الملائكة للمريض دعم نفسي ومواساة له، يخلق حالةً من التفاعل عند المريض تدعم الدواء الذي وصفه له الطبيب، فيشعر المريض بالسعادة وتخفيف الهمّ والألم؛ الأمر الذي يُساعده على النهوض والتغلّب على المرض، وكلّ ذلك يحصل ببركة زيارته قبر الإمام الحسين×.
وقد امتازت الرواية الثانية بميزة أضافتها على عيادة الملائكة للزائر، وهي أنّهم يزورونه غدوةً وعشيةً، بمعنى تكرار الزيارة له مرّتين في اليوم، إحداهما صباحاً، والأُخرى ليلاً، وكلّ ذلك اهتماماً من الله تعالى بزائر الإمام الحسين×.
الأثر السابع: شمول دعاء أهل البيت^ للزائر
ذكرت جملة من الأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت^ ما يترتّب للزائر على زيارته لقبر الإمام الحسين× من الآثار الوضعية العائدة بالنفع لمصلحته، وكان من جملة ما ورد في هذا الصدد أنّ أهل البيت^ يدعون للزائر، ولا شكّ بأنّ دعاء أهل بيت العصمة يحمل من الأبعاد المعرفية ما يوصل بالإنسان إلى أعلى قيم الكمال الإنساني، فالذي يكون مشمولاً بدعائهم^ تترسّخ في نفسه قيم المفاهيم الأخلاقية والعقائدية والثقافية، وغير ذلك من الكمالات النفسية المعنوية والمادّية؛ فإنّ دعاءهم^ مطلق يمكن صرفه لجميع ما يجلب للإنسان الخير والمنفعة في الدنيا والآخرة.
ومن جملة الروايات التي تذكر هذا المعنى ما يلي:
الرواية الأُولى: ما في (كامل الزيارات) «عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله×، قال: قال لي: يا معاوية، لا تدع زيارة قبر الحسين× لخوف؛ فإنّ مَن ترك زيارته رأى من الحسرة ما يتمنّى أنّ قبره كان عنده. أما تُحبّ أن يرى الله شخصك وسوادك فيمَن يدعو له رسول الله| وعليّ وفاطمة والأئمّة^؟»[61].
بعد أن نصح الإمام أبو عبد الله الصادق× معاوية بن وهب بعدم تركه زيارة قبر الإمام الحسين× وإن كان لخوف، ذكر ما يترتّب من الفائدة لزائر قبره الشريف من المصلحة، وهي في المقام رؤية الله تعالى شخص الزائر ضمن الجماعة الذين صار يشملهم دعاء أهل البيت^، وما صدر الدعاء بحقّ هؤلاء إلّا لكونهم حضروا مشهد أبي عبد الله الحسين× وطافوا حوله وزاروه تقرّباً به إلى الله تعالى، وكما تقدّم أنّ دعاء أهل البيت يحمل من البركات ما يجلب للمدعو له الخير في الدنيا والآخرة.
ومعنى (رأى من الحسرة ما يتمنّى أنّ قبره عنده)، أن يتمنّى أن يكون قد قُتل بسبب زيارة الحسين× ويكون قبره عند الحسين×؛ وذلك لما لهذه البقعة الطاهرة من الفضل والكرامة عند الله تعالى، حتّى أنّ الذي ترك زيارتها لخوف من السلطة أو غيرها سوف يندم على ذلك، ويتمنّى لو كان قد قُتل ودفن في هذه البقعة المباركة.
الرواية الثانية: ما في (كامل الزيارات) «عن معاوية بن وهب، قال: استأذنت على أبي عبد الله× فقيل لي: ادخل. فدخلت، فوجدته في مصلّاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربّه وهو يقول: اللّهمّ يا مَن خصّنا بالكرامة، ووعدنا بالشفاعة، وخصّنا بالوصية، وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدةً من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني، وزوّار قبر أبي عبد الله الحسين، الذين أنفقوا أموالهم، وأشخصوا أبدانهم؛ رغبة في برّنا، ورجاءً لما عندك في صلتنا، وسروراً أدخلوه على نبيّك، وإجابة منهم لأمرنا، وغيظاً أدخلوه على عدوّنا، أرادوا بذلك رضوانك. فكافِهم عنّا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم، واكفهم شرّ كلّ جبّار عنيد، وكلّ ضعيف من خلقك وشديد، وشرّ شياطين الإنس والجنّ، وأعطهم أفضل ما أمّلوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم.
اللّهمّ إنّ أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافاً منهم على مَن خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيّرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تتقلّب على حفرة أبي عبد الله الحسين×، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمةً لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللّهمّ إنّي أستودعك تلك الأبدان وتلك الأنفس، حتى توافيهم من الحوض يوم العطش.
فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت: جُعلت فداك، لو أنّ هذا الدعاء الذي سمعت منك كان لمـَن لا يعرف الله} لظننت أنّ النار لا تطعم منه شيئاً أبداً، والله لقد تمنّيت أنّي كنت زرته ولم أحجّ. فقال لي: ما أقربك منه! فما الذي يمنعك من زيارته؟! ثمّ قال: يا معاوية، ولمَ تدع ذلك؟ قلت: جُعلت فداك، لم أدرِ أنّ الأمر يبلغ هذا كلّه. فقال: يا معاوية، مَن يدعو لزوّاره في السماء أكثر ممّن يدعو لهم في الأرض»[62].
لعلّ من أوضح مصاديق هذا الأثر الوضعي هو هذه الرواية التي تحمل بين طيّاتها جُمل الدعاء السامية المعاني لزوّار قبر الإمام أبي عبد الله الحسين×، الصادرة عن الإمام الصادق×، فإنّ الرواية لم تكن في موضع الإخبار عن الدعاء بحقّ الزائر، وإنّما هي بنفسها كانت تمثّل واحداً من الأدعية الصادرة من قِبل الإمام المعصوم× بحقّ الزائر.
نعم، إنّ الرواية في الوقت الذي جسّدت فيه هذا الدعاء عمليّاً، ذكرت في ذيلها إخباراً من الإمام× بأنّ مَن يدعو لزوّار الإمام الحسين× من المخلوقات السماوية أكثر من الذين يدعون لهم في الأرض، وهذا يعني أنّ هناك موجودات أُخرى غير أهل البيت^ يدعون لزائر قبر أبي عبد الله×.
الأثر الثامن: الحياة سعيداً
السعادة في اللغة من سعد، والسعد هو اليُمن، وهو نقيض النحس... والسعادة خلاف الشقاوة... وقد يسعد سعادةً فهو سعيد[63].
وتُعرّف اصطلاحاً بأنّها «توفّر أسباب النعمة»[64]. وعليه؛ فهي ضالّة الإنسان ومطلبه وهدفه، وهي من الأُمور الاكتسابيّة[65]؛ لذا فكلّ إنسان يبحث عن السعادة ويطلبها من أماكنها.
وهي شعور ينبع من داخل النفس يبحث عن السكينة والطمأنينة في القلب، تجعل منه أن ينظر للحياة بشكل إيجابي. وهي كذلك شعور نسبي بحالة الرضا والتوازن والاستقرار.
وتحقيقها يُطلب من طرق عديدة، منها زيارة الإمام الحسين×، فهي من الآثار الوضعية الناتجة عن الزيارة، فينال الإنسان سعادته بعد أن يحقّق فعل زيارة الإمام الحسين×.
وقد ورد عن أهل البيت^ في فضل زيارة الإمام الحسين× ما يدلّ على هذا المعنى، ومن ذلك ما رواه في (كامل الزيارات): «عن عبد الملك الخثعمي، عن أبي عبد الله×، قال: قال لي: يا عبد الملك، لا تدع زيارة الحسين بن علي’، ومُر أصحابك بذلك، يمدّ الله في عمرك، ويزيد الله في رزقك، ويحييك الله سعيداً، ولا تموت إلّا سعيداً، ويكتبك سعيداً»[66].
إنّ من جملة ما يتطلّع إليه الإنسان هو كيفيّة تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة؛ فإنّها الهدف المرجو لكلّ شخص، لذلك حدّدت بعض الثقافات تحقيق السعادة بتراكم الثروة الماليّة، بينما حدّدتها ثقافات أُخرى بإعمال القوّة، أو غيرها من الأعمال التي تُشعر الإنسان بالارتياح والهيمنة على الأُمور الدنيوية وكونها تنساق طواعيةً له.
ومعنى أن يكون الإنسان سعيداً أن يكون راضياً عن حياته وما يجري فيها الرضا التامّ، إلّا أنّ حقيقة السعادة تكمن في أن يكون الإنسان سعيداً مع الله تعالى، وهو تعبير آخر عن حصول رضا الله تعالى عن هذا الإنسان، وهذا لا يمكن تحقّقه إلّا إذا التزم الإنسان بالتعاليم الإلهيّة وطبّقها متّبعاً هدي النبي| وأهل بيته^، فيكون بذلك حريصاً على أداء الواجبات والمحافظة على أوقاتها؛ فإنّه بالإضافة إلى ما يتمتّع به الإنسان من ثروة وأموال وأمتعة الدنيا الضرورية، يُعتبر رضا الله تعالى هو لبّ الشعور بالسعادة.
وواحد من الأعمال المهمّة التي يؤدّيها الإنسان تقرّباً إلى الله تعالى وطلباً لحصول السعادة له، هو أداؤه زيارة قبر الإمام الحسين×؛ فإنّه كما ورد في الحديث المتقدّم أنّ الله تعالى يُحيي زائر الحسين× حياةً سعيدةً ويكتبه سعيداً، ولعلّ السرّ في ذلك هو مشاركة الزائر لما عاشه الإمام الحسين× وأصحابه من حالة السعادة التي أكرمهم الله} بها، فقد ورد في زيارة الأربعين: «اللّهمّ أنّي أشهد أنّه وليك وابن وليك... أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة»[67].
ويكمن معنى السعادة في اهتمام الإمام الحسين× وأصحابه كثيراً بأداء العبادة تقرّباً إلى الله}؛ وذلك لشعورهم بأنّ حقيقة السعادة هي الطاعة لله تعالى والتقرّب إليه، فلذلك قضت هذه الكوكبة من المؤمنين الأوفياء ليلتها الأخيرة من الحياة بإحياء العبادة، وتلاوة القرآن الكريم، والابتهال إليه}، فقد ورد في كتب المقاتل:«وبات الحسين× وأصحابه تلك الليلة ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد، وقائم وقاعد»[68].
الملحق: موانع تحقّق آثار زيارة الإمام الحسين× الوضعية
إلى هنا ينتهي بنا الكلام فيما استقصيناه وتتبّعناه من الآثار الوضعية الدنيوية الإيجابية التي تصبّ في مصلحة الإنسان عند زيارته قبر الإمام الحسين×، إلاّ أنّه يمكن القول بأنّ بعض هذه الآثار أو ربّما كلّها لا يتحقّق حتّى للذي يزور قبر الإمام× مراراً وتكراراً، والسبب في ذلك أنّ هناك مجموعة موانع وحواجز تُعيق حصول تلك الآثار، أو تقف مانعاً دون تحقّقها أو بعضها. لذا سوف نتحدّث بشكل موجز في هذا الملحق عن تلك الموانع والأسباب.
يقول الشيخ جعفر التستري في (الخصائص الحسينيّة): «اعلم أنّ جميع ما يُذكر في ثواب الأعمال وخواصّها فإنّما ذلك لبيان مقتضاها من حيث هي، كما في خواصّ الأدوية، ولكلّ منها موانع تدفع مقتضاها، وذلك لا ينافي ثبوت الخاصّية، فالسكنجبين مثلاً قاطع للصفراء، فإذا لم يقطع الصفراء لعروض المانع فيما يؤكل قبله أو بعده، أو لانقلاب في المزاج، فلا ينافي كونه قاطعاً للصفراء. فجميع ما يُذكر في فضائل الأعمال والأدعية ونحوها قد تقابلها موانع تدفع خاصّيّتها وترفعه، والمانع قد يدفع أثرها بالكلّية، وقد يبقى منه شيء»[69].
وقبل الدخول في ذكر موانع تحقّق أثر الزيارة نشير بصورة موجزة إلى أنّ هناك شروطاً يجب توفّرها في الزائر لأجل حصوله على تلك الآثار، ومنها:
أوّلاً: صفاء الذهن ونقاؤه ممّا يشوبه من الأُمور الخارجة عن آداب الزيارة، وهو حضور القلب وخشوعه بمحضر الإمام×، بمعنى التفرّغ التامّ لأداء مراسم الزيارة، وذلك من حين خروج الزائر من منزله حتّى بلوغه كربلاء والضريح المقدّس؛ لمشابهة السفر إلى الزيارة بالسفر إلى الحجّ، فيلزم الزائر من الأُمور التي تلزم الحاجّ، وإلى هذا المعنى تُشير رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله×، قال: قلت له: «إذا خرجنا إلى أبيك أفلسنا في حجّ؟ قال: بلى. قلت: فيلزمنا ما يلزم الحاجّ؟ قال: ماذا؟ قلت: من الأشياء التي تلزم الحاجّ. قال: يلزمك حسن الصحبة لمـَن صحبك، ويلزمك قلّة الكلام إلّا بخير، ويلزمك كثرة ذكر الله، ويلزمك نظافة الثياب، ويلزمك الغُسل قَبل أن تأتي الحائر، ويلزمك الخشوع وكثرة الصلاة، والصلاة على محمّد وآل محمّد، ويلزمك التوقير لأخذ ما ليس لك، ويلزمك أن تغضّ بصرك، ويلزمك أن تعود على أهل الحاجة من إخوانك إذا رأيت منقطعاً، والمواساة، ويلزمك التقية التي قوام دينك بها، والورع عمّا نُهيت عنه، والخصومة، وكثرة الأيمان والجدال الذي فيه الأيمان، فإذا فعلت ذلك تمّ حجّك وعمرتك، واستوجبت من الذي طلبت ما عنده بنفقتك أن تنصرف بالمغفرة والرحمة والرضوان»[70].
ثانياً: المعرفة الحقّة بالمزور، ومعنى كون الزائر عارفاً بحقّ الإمام المزور علمه بأنّه إمام مفترض الطاعة، وأنّ الله تعالى أكرمه بهذا المقام وجعله له، وهو مقام الخلافة الإلهيّة، فقد ورد في إحدى زيارات الإمام الحسين×: «أتيتك يا مولاي يابن رسول الله زائراً عارفاً بحقّك»[71].
وأمّا موانع تحقّق الآثار فيمكن إجمالها فيما يلي:
ليس شرطاً أو ضروريّاً أن يقع الأثر مباشرةً بعد فعل الزيارة، وإنّما ربّما يتأخّر عليه بمدّة ليست بقصيرة؛ وذلك لمصلحة في التأخير. نعم، قد يرى العبد الزائر أنّ المصلحة في تحقّق الأثر الذي يتوخّاه من فعل الزيارة، لكنّه غير مهتمّ أو ملتفت إلى الحكمة الإلهيّة في التأخير أو التقدير الربّاني في ذلك، أو ربّما أنّ ما يبتغي الزائر تحقّقه ليس في مصلحته حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهيّة، فلا يتحقّق الأثر، كما هو مصداق قوله تعالى: (وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)[72].
ولعلّ في بعض زيارات الإمام الحسين× ميزةً خاصّةً تحقّق أثراً ما حتّى لو حصل المانع من تحقّق غيره؛ لذا يقول التستري في (الخصائص الحسينيّة): «فاعلم إنّ لزيارة الحسين× فضيلةً خاصّةً فاقت كلّ الفضائل، وهي أنّه لو تحقّقت الموانع من تأثيراتها... فلا يمكن ذهاب كلّ تأثيراتها، ولو مع جميع الموانع؛ لأنّ طرق التخليص بها ومحالّه كثيرة، فكلّما حصل مانع من أحد تأثيراتها حصل مقتضٍ آخر لتأثير آخر، وإذا حصل لها أيضاً مانع أو بطل بمقتضاه، تحقّق مقتضٍ آخر»[73].
لعلّ فرداً من أفراد الزائرين يحصل على نوع من الآثار الموعود بها أو على نوعين، ويحرم من نوع أو اثنين أو أكثر، وذلك حسب كونه قد استحقّ هذا النوع دون غيره بحسب ما تقتضيه المصلحة والحكمة الإلهيّة[74]، فإنّه من المعلوم تفاوت الزوّار في الحصول على الآثار، فقد يحصل أحدهم على جميع الآثار المذكورة في الزيارة، وقد يحصل ثانٍ على أحدها فقط، وثالث على بعضٍ منها، ورابع قد لا يحصل على شيء منها.
الذنوب أو المعاصي، فهي من أشدّ الموانع والحواجز التي تقطع الطريق أمام تحقّق الآثار على أداء الفعل العبادي؛ لذا يجب أن يُصاحب فعل أداء الزيارة الابتعاد عن المعاصي وارتكاب المآثم؛ لكي يسهل تحقّق أثر الزيارة الوضعي وحصول الزائر على المنفعة.
ولكنّ هناك خصوصية في زيارة الإمام الحسين× ذكرها التستري في (الخصائص الحسينيّة)، فقال في هذا الصدد: «فإذا منع مانع من ظهور الأثر في المحلّ المقرّر، لا جرم بطل الأثر بالكلّية، ولا يظهر ثانياً في مقام آخر من مواطن الاحتياج، ولكنّ زيارة الحسين× لا يبطل أثرها، وكلّما منعت الذنوب من تأثير لها في محلّ ظهر في محلّ آخر»[75].
ولعلّ في هذا الكلام تحفيز وتشجيع للزائر على الاهتمام بالزيارة وعدم التهاون فيها من جانب، وعلى تركه ارتكاب المعاصي لمشاركتها في منع أو حجز بعض الآثار الإيجابيّة من التحقّق فيما يُرجى من زيارة الإمام الحسين× من جانب آخر.
عدم المداومة على فعل الزيارة؛ إذ تحتاج بعض الآداب والمستحبّات المداومة عليها وتكرارها لتحقّق أثرها، والزيارة حالها حال سائر الآداب الأُخرى التي إذا لم يحقّق الزائر المداومة على فعلها فليس شرطاً أن تحقّق آثارها الوضعية. فقد روي عن الإمام الصادق× أنّه علّم رجلاً ذا علّة عملاً لرفعها، ثمّ قال× له: «إنّه لا ينفعك حتّى تتيقّن أنّه ينفعك فتبرأ منها، ثمّ تداوم على ذلك فإنّ الله يشفيك»[76].
وكذلك هي الحال في زيارة الإمام الحسين×، فإنّه بعد الاعتقاد الجازم والتصديق بمنزلة المزور وعظم شأنه، لا بدّ من المداومة على فعل الزيارة بالقدر الذي يستطيع معه المداومة؛ لكي تتحقّق آثارها.
ألّا يُصاحب فعل أداء الزيارة فعل آخر يناقض تحقيق أثرها؛ فإنّ كلّ ما يقوم به الإنسان من عمل له خواصّه وآثاره المترتّبة عليه، فكما أنّ الأدوية لها خواصّها بشرط عدم تناول شيء يبطل مفعولها، فكذلك الأعمال والأقوال، فكون زيارة الإمام الحسين× ممّا يطيل في العمر ويزيد في الرزق مثلاً مشروط بعدم الإقدام على عمل آخر يوجب نقصان العمر وحرمان الرزق[77].
ربّما احتاجت بعض الآداب والمستحبّات إلى شروط معيّنة في أدائها، فلا يتحقّق أثرها إلّا مع إتقانها والإتيان بها بالشروط والجزئيّات المفترضة فيها، فهي بالرغم من استحبابها وعدم فرضها إلّا أنّها ألزمت مؤدّيها بطريقة أو صيغة معيّنة يجب أن تقع أو تؤدّى طبقها، فإذا أخلّ الإنسان بشيء من ذلك حُرِم أثرها أو منفعتها.
فقد روي «أنّ رجلاً سأل الصادق× فقال: إنّي سمعتك تقول: إنّ تربة الحسين× من الأدوية المفردة، وأنّها لا تمرّ بداء إلّا هضمته. فقال: قد كان ذلك، أو قد قلت ذلك، فما بالك؟ فقال: إنّي تناولتها فما انتفعت بها. قال: أما أنّ لها دعاءً، فمَن تناولها ولم يدعُ به واستعملها لم يكد ينتفع بها. قال: فقال: ما يقول إذا تناولها؟ قال: تُقبّلها قَبل كلّ شيء وتضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمصة؛ فإنّ مَن تناول منها أكثر فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا. فإذا تناولت فقل: اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضها وبحقّ الملك الذي خزنها، وأسألك بحقّ الوصي الذي حلّ فيها، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تجعله شفاءً من كلّ داء، وأماناً من كلّ خوف، وحفظاً من كلّ سوء. فإذا قلت ذلك فاشددها في شيء واقرأ عليها إنّا أنزلناه في ليلة القدر؛ فإنّ الدعاء الذي تقدّم لأخذها هو الاستئذان عليها، واقرأ إنّا أنزلناه ختمها»[78].
الخاتمة
إنّ الحديث عن زيارة الإمام الحسين× حديث ذو أبعاد ومفاهيم كثيرة، يتقدّمها جانب المعاني السامية التي تحملها هذه الزيارة من تثبيت المبادئ والقيم التي استشهد من أجلها الإمام الحسين× في نفوس الزائرين، واستحضار معانيها في عقولهم، ممّا يقوّي الأواصر والروابط مع الإمام المزور×. هذا بالإضافة إلى الآثار المعنوية والمادّية المترتّبة على فعل الزيارة التي تُصيب الزائر، وهي بقدر كثرتها لا يستطيع الباحث الإلمام بها أو استيعابها في مقال أو أكثر.
فقد استعرضنا في هذا المقال في كلا قسميه بعض نصوص الروايات الشريفة النادبة لزيارة الإمام الحسين×، التي تحمل المعاني الدالّة على بيان الآثار الوضعية الدنيوية التي تتحقّق للإنسان نتيجة زيارته قبر الإمام الحسين×، فذكرنا ثمانيةً من تلك الآثار، وهي: أثر زيارة الإمام الحسين× في زيادة الرزق، ومدّ العمر، وقضاء الحاجة، ودفع مدافع السوء، واستجابة الدعاء، وعيادة الملائكة لزائر الإمام الحسين×، وشمول دعاء أهل البيت^ له، والحياة السعيدة.
وقد اتّضح أنّ هذه الآثار تحفّز وتشجّع شيعة أئمّة أهل البيت^ على إتيان قبر الإمام الحسين× وزيارته، وأنّها قد رتّبت حصول مثل هذه المنافع والفوائد للزائر جرّاء ما يقوم به من إحياء هذه الشعيرة المقدّسة.
وقد ختمت هذه الآثار بذكر ملحق يستعرض الموانع التي تعيق حصول الأثر أو تأخّر تحقّقه بالرغم من أداء فعل الزيارة، وكان غرضنا من ذكر هذا الملحق اطّلاع الزائر على ما يحجب عنه منافع الزيارة.
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1ـ الآثار الوضعية في الكتاب والسنّة، الشيخ عبد الرسول آل عنوز، الناشر: منشورات الداوري، قم ـ إيران، الطبعة الثانية، 1425هـ.
2ـ أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت538هـ)، الناشر: دار ومطابع الشعب، القاهرة ـ مصر، 1960م.
3ـ إعلام الورى بأعلام الهدى، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت548هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1417هـ
4ـ إقبال الأعمال (مضمار السبق في ميدان الصدق)، السيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (ت664هـ)، تحقيق: جواد القيّومي الأصفهاني، مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأُولى، 1414هـ.
5ـ الأمالي، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة مؤسّسة البعثة، الناشر: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1414هـ.
6ـ الأمالي، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: قسم الدراسات الإسلاميّة مؤسّسة البعثة، الناشر: مؤسّسة البعثة، طهران ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
7ـ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الناشر: مؤسّسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 1413هـ/1992م.
8ـ بشارة المصطفى| لشيعة المرتضى×، أبو جعفر محمّد بن أبي القاسم الطبري (القرن السادس الهجري)، تحقيق: جواد القيّومي الأصفهاني، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1420هـ.
9ـ تاج العروس من جواهر القاموس، السيّد محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت1205هـ)، تحقيق: علي شيري، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، 1414هـ/1994م.
10ـ التفسير الكبير، محمّد بن عمر المعروف بفخر الدين الرازي (ت606هـ )، الطبعة الثالثة (وهي الطبعة التي اعتمدتها مكتبة أهل البيت الإلكترونيّة، الإصدار الثاني، 1433هـ).
11ـ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت460هـ)، تحقيق: السيّد حسن الموسوي الخرسان، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة، طهران ـ إيران، الطبعة الثالثة، 1364هـ.ش.
12ـ تهذيب اللغة، أبو منصور محمّد بن الأزهري الهروي (ت370هـ)، تحقيق: محمّد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، 2001م.
13ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، الناشر: منشورات الشريف الرضي، قم ـ إيران، الطبعة الثانية، 1368هـ.ش.
14ـ جامع أحاديث الشيعة، السيّد حسين الطباطبائي البروجردي (ت1383هـ)، المطبعة العلميّة، قم ـ إيران، 1399هـ.
15ـ الخصائص الحسينيّة (خصائص الحسين× ومزايا المظلوم)، الشيخ جعفر بن المولى حسين التستري (ت1303هـ)، تحقيق، السيّد جعفر الحسيني، الناشر: مكتبة ودار الحوراء للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان.
16ـ درر الأخبار من بحار الأنوار، السيّد مهدي حجازي، الناشر: دفتر مطالعات تاريخ ومعارف إسلامي، الطبعة الأُولى، 1419هـ.
17ـ رياض السالكين في شرح صحيفة الساجدين، السيّد علي خان الحسيني المدني الشيرازي (ت1120ت)، تحقيق: السيّد محسن الحسيني الأميني، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة ـ إيران، الطبعة الرابعة، 1415هـ.
18ـ شبكة الإنترنت العالميّة، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرّة.
19ـ شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميري (573هـ)، تحقيق: مجموعة من المحقّقين، الناشر: دار الفكر المعاصر، بيروت ـ إيران، دار الفكر دمشق، الطبعة الأُولى، 1999م.
20ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة، إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت ـ لبنان، الطبعة الرابعة، 1407هـ/1987م.
21ـ عدّة الداعي ونجاح الساعي، أحمد بن فهد الحلّي (ت841هـ)، تصحيح أحمد الموحّدي القمّي، الناشر: مكتبة الوجداني، قم المقدّسة ـ إيران.
22ـ العروة الوثقى، السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي (ت1377هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
23ـ الفوائد الطوسيّة، الشيخ محمّد بن الحسن المعروف بالحرّ العاملي (ت1104هـ)، تحقيق: الحاجّ السيّد مهدي اللازوردي، والشيخ محمّد درودي، المطبعة العلميّة، قم ـ إيران، 1403هـ.
24ـ قرب الإسناد، أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري (ت304هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1413هـ.
25ـ الكافي، أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت329هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، الناشر: دار الكتب الإسلاميّة، طهران ـ إيران، الطبعة الخامسة، 1363هـ.ش.
26ـ كامل الزيارات، أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي (ت368هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيّومي، الناشر: مؤسّسة نشر الفقاهة، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
27ـ كتاب الخصال، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ إيران، 1403هـ.
28ـ كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، أبو جعفر محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي (ت598هـ )، تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة، قم ـ إيران، الطبعة الثانية 1410هـ.
29ـ كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ)، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، الناشر: مؤسّسة دار الهجرة، إيران، الطبعة الثانية، 1409هـ.
30ـ كتاب المزار (مناسك المزار)، الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري المعروف بالشيخ المفيد (ت413هـ)، تحقيق: آية الله الشيخ محمّد باقر الأبطحي، الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1414هـ/1993م.
31ـ كتاب المزار، محمّد بن مكّي العاملي المعروف بالشهيد الأوّل (ت786هـ)، تحقيق ونشر: مدرسة الإمام المهدي#، قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1410هـ.
32ـ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت1228هـ)، تحقيق: مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان، الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأُولى، 1422هـ.
33ـ كفاية الأثر في النصّ على الأئمّة الاثني عشر، أبو القاسم علي بن محمّد بن علي الخزاز القمّي الرازي (القرن الرابع الهجري)، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي، الناشر: انتشارات بيدار، قم المقدّسة ـ إيران، 1401هـ.
34ـ لسان العرب، جمال الدين محمّد بن مكرم المعروف بابن منظور الإفريقي (ت711هـ)، الناشر: نشر أدب الحوزة، قم ـ إيران، 1405هـ.
35ـ اللهوف في قتلى الطفوف (مقتل الحسين×)، علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس الحسيني(ت664هـ)، الناشر: أنوار الهدى، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1417هـ.
36ـ المجتنى من الدعاء المجتبى، السيّد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس (ت664هـ)، تحقيق: صفاء الدين البصري.
37ـ مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (ت1085هـ)، الناشر: مرتضوي، طهران ـ إيران، الطبعة الثانية.
38ـ المزار، أبو عبد الله محمّد بن جعفر المعروف بابن المشهدي (المتوفى في القرن السادس الهجري)، تحقيق: الشيخ جواد القيّومي الأصفهاني، الناشر: مؤسّسة الآفاق طهران، مؤسّسة النشر الإسلامي قم ـ إيران، الطبعة الأُولى، 1419هـ.
39ـ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت1320هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، الطبعة الأُولى، 1408هـ/1987م.
40ـ مستدرك سفينة البحار، الشيخ على النمازي الشاهرودي (ت1405هـ)، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة، قم ـ إيران، 1418هـ.
41ـ مصباح المتهجّد، أبو جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي (ت460هـ)، الناشر: مؤسّسة فقه الشيعة، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى،1411هـ.
42ـ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة، د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة ـ مصر.
43ـ معجم لغة الفقهاء، محمّد رواس قلعجي، الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1408هـ/1988م.
44ـ معجم متن اللغة، أحمد رضا، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت ـ لبنان، 1958م.
45ـ معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ)، تحقيق: عبد السلام محمّد هارون، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي، 1404هـ.
46ـ مكارم الأخلاق، الحسن بن الفضل الطبرسي (ت548هـ)، الناشر: منشورات الشريف الرضي، الطبعة السادسة، 1392هـ/1972م.
47ـ ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، محمّد باقر المجلسي (ت1111هـ)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي، قم ـ إيران، 1406هـ.
48ـ مَن لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت381هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم ـ إيران، الطبعة الثانية.
49ـ النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمّد الشيباني الجزري (ت606هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمّد الطانجي، الناشر: مؤسّسة إسماعيليّان للطباعة والنشر والتوزيع، قم المقدّسة ـ إيران، الطبعة الرابعة.
50ـ وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة)، الشيخ محمّد بن الحسن المعروف بالحرّ العاملي (ت1104هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت^لإحياء التراث، قم ـ إيران، الطبعة الثانية، 1414هـ.
[1] اُنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين: ج7، ص328.: والزمخشـري، محمود بن عمر، أساس البلاغة: ص464.
[2] الجوهري، إسماعيل بن حمّاد، الصحاح: ج3، ص1208.
[3][3] المجلسي، محمّد باقر، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: ج9، ص110.
[4] الحميري، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد: ص76.
[5] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص29.
[6] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص284.
[7] النساء: الآية148.
[8] آل عمران: الآية30.
[9] التوبة: الآية37.
[10] الشاهرودي النمازي، علي، مستدرك سفينة البحار: ج8، ص510.
[11] حجازي، السيّد مهدي، درر الأخبار من بحار الأنوار: ص506.
[12] كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء: ج4، ص216.
[13] الصدوق، محمّد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص582.
[14] البروجردي، السيّد حسين، جامع أحاديث الشيعة: ج12، ص381.
[15] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص270ـ 271.
[16] ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة: ج2، ص279.
[17] الزبيدي، مرتضى، تاج العروس: ج19، ص405.
[18] المدني، علي خان، رياض السالكين: ج1، ص225.
[19] عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: ج2، ص81.
[20] الفخر الرازي، محمّد بن عمر، التفسير الكبير: ج5، ص107.
[21] غافر: الآية60.
[22] البقرة: الآية186.
[23] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص466.
[24] اُنظر: ابن طاووس، علي بن موسى، المجتنى من الدعاء المجتبى: ص26، مقدّمة التحقيق.
[25] اُنظر: ابن فهد الحلّي، أحمد، عدّة الداعي ونجاح الساعي: ص57.
[26] الخزّاز القمّي، علي بن محمّد، كفاية الأثر: ص16ـ17.
[27] اُنظر: النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص335.
[28] ابن فهد الحلّي، أحمد، عدّة الداعي ونجاح الساعي: ص48.
[29] ابن المشهدي، محمّد بن جعفر، المزار: ص496ـ497.
[30] الطوسي، محمّد بن الحسن، الأمالي: ص317.
[31] اُنظر: الطبري، محمّد بن علي، بشارة المصطفى: ص327.
[32] اُنظر: الطبرسي، الفضل بن الحسن، إعلام الورى بأعلام الهدى: ج1، ص341.
[33] اُنظر: شبكة الإنترنت العالميّة، موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرّة، قبّة.
[34] الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج2، ص138.
[35] الزبيدي، مرتضى، تاج العروس: ج2، ص301.
[36] ابن الأثير، المبارك بن محمّد، النهاية في غريب الحديث والأثر: ج4، ص3.
[37] الصدوق، محمّد بن علي، الأمالي: ص759.
[38] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص458ـ 459.
[39] اُنظر: الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص567.
[40] اُنظر: الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص537.
[41] اُنظر: النوري، الميرزا حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص346.
[42] الحائر الحسيني هو مصطلح يُطلق على البقعة الطاهرة التي تحتضن قبر الإمام الحسين×. وقال ابن إدريس الحلّي: «والمراد بالحائر ما دار سور المشهد والمسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه؛ لأنّ ذلك هو الحائر حقيقةً؛ لأنّ الحائر في لسان العرب: الموضع المطمئن الذي يُحار الماء فيه». ابن إدريس الحلّي، محمّد بن منصور، السرائر، ج1، ص242.
وقال العلاّمة الطريحي: «الحائر وهو في الأصل مجمع الماء، ويراد به حائر الحسين×، وهو ما حواه سور المشهد الحسيني على مشرّفه السلام». الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين: ج3، ص281.
[43] الصدوق، محمّد بن علي، الخصال: ص27.
[44] اُنظر: ابن فهد الحلّي، أحمد بن فهد، عدّة الداعي ونجاح الساعي: ص48.
[45] الصدوق، محمّد بن علي، ثواب الأعمال: ص91.
[46] غافر: الآية60.
[47] اُنظر: رضا، أحمد، معجم متن اللغة: ج1، ص594. واُنظر: الحميري، نشوان، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: ج2، ص1222.
[48] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص435.
[49] اُنظر: المفيد، محمّد بن محمّد، المزار: ص135.
[50] اُنظر: ابن المشهدي، محمّد بن جعفر، المزار: ص357.
[51] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج7، ص26.
[52] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص313.
[53] الزبيدي، مرتضى، تاج العروس: ج5، ص134.
[54] اليزدي، السيّد كاظم، العروة الوثقى: ج2، ص17.
[55] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص175ـ 176.
[56] الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص581.
[57] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص233ـ235.
[58] المصدر السابق: ص312.
[59] اُنظر: قلعچي، محمّد، معجم لغة الفقهاء: ص69.
[60] اُنظر: المصدر السابق.
[61] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص227. وكذلك رواه في موضع آخر في ص230، مع زيادة: («أما تُحبّ أن تكون ممّن ينقلب بالمغفرة لما مضى، ويُغفر لك ذنوب سبعين سنةً؟! أما تُحبّ أن تكون ممّن يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب يتبع به؟! أما تُحبّ أن تكون غداً ممّن يُصافحه رسول الله|؟!». وكذلك رواه مع هذه الزيادة الشيخ الطوسي في (تهذيب الأحكام): ج6، ص47.
[62] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص51ـ52.
[63] اُنظر: ابن منظور، محمّد بن مكرم، لسان العرب: ج3، ص313.
[64] مكارم الشيرازي، ناصر، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج7، ص61.
[65] اُنظر: المصدر السابق: ص62.
[66] ابن قولويه، جعفر بن محمّد، كامل الزيارات: ص286. ورواه عنه كذلك الحرّ العاملي في وسائل الشيعة: ج14، ص431.
[67] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ص101ـ102.
[68] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص57.
[69] التستري، الشيخ جعفر، الخصائص الحسينية: ص283.
[70] الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة: ج14، ص527ـ 528.
[71] الشهيد الأوّل، محمّد بن مكّي، المزار: ص168.
[72] البقرة: الآية216.
[73] التستري، الشيخ جعفر، الخصائص الحسينيّة: ص284.
[74] اُنظر: الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الفوائد الطوسية: ص462.
[75] التستري، الشيخ جعفر، الخصائص الحسينية: ص284.
[76] الطبرسي، الحسن بن الفضل، مكارم الأخلاق: ص395.
[77] اُنظر: آل عنوز، عبد الرسول، الآثار الوضعيّة: ص20.
[78] الطوسي، محمّد بن الحسن، مصباح المتهجّد، ص734.