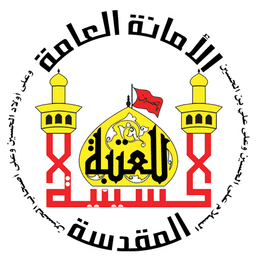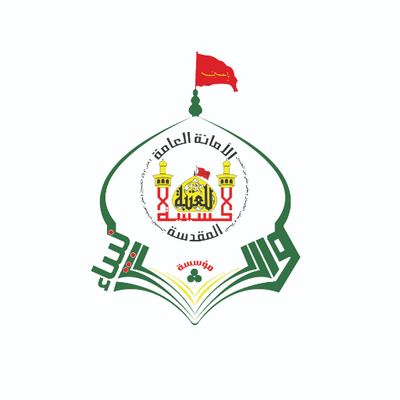المقدّمة
إنّ فرضية البحث تدور حول مسألة حاصلها: هل تجسّدت عقيدة التوحيد في سلوك ومواقف الإمام الحسين وأهل بيته^ وأصحابه رضوان الله عليهم جميعاً؟ وما هي النصوص التي أشارت إلى ذلك، والتي وردت في زيارة الإمام الحسين×؟
وقبل الشروع في موضوع البحث والإجابة عن الفرضية السؤال المطروح في لا بدّ من مقدّمة تمهيدية، يتمّ من خلالها بيان حقيقة التوحيد، وما ينبغي الاعتقاد به، ومدى أهمّية الإيمان بهذا المعتقد وهذه الحقيقة. وكذلك تعريف مفردات البحث؛ ليتّضح للمتلّقي حدود دائرة البحث ومفاهيمه التصوّرية
ومن هنا؛ تطرّقنا في المقدّمة إلى بيان عدّة نقاط، وهي كالآتي:
أوّلاً: التعريف اللغوي بمفردات البحث
1ـ مظاهر: المظاهر في اللغة مفردة لجمع مظهر، مأخوذة من ظهر تبيَّن وبرز وانكشف بعد الخفاء، والمظهر بالتخفيف هو الوجه[1]. وللمفردة معانٍ أُخرى مثل القوّة، فيقال: رجل مظهر، بمعنى القوي[2].
2ـ التوحيد: وهو في اللغة: «الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله الواحد الأحد ذو التوحّد والوحدانية»[3]. ويقال: «الله الأوحد والمتوحّد ذو الوحدانية »[4].
ثانياً: التعريف الاصطلاحي بمفردات البحث
1ـ مظاهر: تعريف المظاهر في المقام لا يختلف كثيراً عمّا عليه من معنىً لغوي، فهو وجه الشيء وطلعته، أو الهيئة الخارجية للشيء، أو ما يظهر له من أسماء وصفات يُعرف بها، فأسماء الله تعالى وصفاته مظاهر له يُعرف من خلالها.
ومَن يُعبّر عن أسماء الله تعالى وصفاته هم الأنبياء والرسل والأئمّة^، فهم خلفاء الله تعالى الذين يمثّلون صفاته، يقول تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً)[5]، «ومن شأن الخلافة أن يُحاكي الخليفة من استخلفه في صفاته وأعماله، فعلى خليفة الله في الأرض أن يتخلّق بأخلاق الله، وأن يريد ويفعل ما يريده الله، ويحكم ويقضي بما يقضي به الله والله يقضي بالحقّ ويسلك سبيل الله ولا يتعدّاها»[6].
٢ـ التوحيد: معنى التوحيد في الاصطلاح لا يختلف كثيراً عن المعنى اللغوي، وهو «الإيمان بالله تعالى وبوحدانيّته تبارك وتعالى»[7]. ويُعدّ أهمّ الأُسس في العقيدة الإسلامية، والركن فيها، وأعلى مراتب الاعتقاد فيها، فلا يمكن أن يستقيم الدين بغير التوحيد، والاعتقاد بأنّ الله تعالى واحد لا شريك له في جميع شؤون الكون وعالم الخليقة، وليس لغير الله تعالى دور إنشاء العالم وخلقه[8].
ثالثاً: كلام عن عقيدة التوحيد
قسّم علماء الكلام التوحيد إلى:
التوحيد الذاتي: وهو الاعتقاد بأنّ الله تعالى لا شريك له ولا مثيل، ولا ثاني له ولا ندّ له.
والتوحيد الصفاتي: وهو الاعتقاد بأنّ صفاته عين ذاته، فلا يكون هناك اثنينية بين الصفة والموصوف.
والتوحيد الأفعالي: وهو الاعتقاد بأنّه تعالى غني لا يحتاج إلى غيره، ولا يحتاج إلى معين في فعله.
والتوحيد العبادي: وهو الاعتقاد بأنّه تعالى لا معبود سواه، وهو أعلى مراتب التوحيد.
وكذلك ذكروا أنّ من المراتب: التوحيد في الحكم، والتوحيد في الطاعة[9].
ولا خلاف في أنّ الله تعالى واحد في الخالقية، وهذا أمر فطري، لكنّ ما واجهه الأنبياء والأوصياء^ من بعدهم هو الشرك في التدبير الذي يؤدّي إلى الشرك في الربوبية، وبالتالي الشرك في العبودية.
وقد اختلف بنو البشر إلى طوائف متعدّدة وأديان متنوّعة في مسألة الشرك بالله تعالى من جهة الشرك في الربوبية؛ فمنهم مَن اتّخذ البشر كالرهبان والأحبار أو الفراعنة: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ)[10]. ومنهم مَن اتّخذ النجوم أرباباً من دون الله تعالى، ومنهم اتّخذ الأصنام، ومنهم مَن اتّخذ الجبال أو الحيوانات كالبقر وبعض الطيور، ومنهم مَن اتّخذ العادات والمقدّسات الاجتماعية معبوداً له؛ حيث يعتقد هذا البعض من الناس بتأثير جميع تلك الأُمور في الكون بنحو الاستقلال عن الله تعالى، وهذا النوع من التصوّر يجعلها أنداداً ونظراء لله تعالى، تفعل وتؤثّر في نفعهم وضرّهم، وفي متطلّبات الحياة من حرب، أو سلم، أو سفر، أو مطر، أو رياح، أو حرّ، أو برد.
وقد واجه القرآن الكريم هذا النوع من الاعتقاد، وكذلك كانت مهمّة الأنبياء والرسل والأئمّة^ تركّز على مواجهة هذا الاعتقاد الفاسد والفكر المنحرف، وتؤكّد نفي التأثير على نحو الحقيقة والاستقلال في الوجود عن غير الله تعالى، وتُبطل جميع تلك المزاعم والاعتقادات الفاسدة من خلال التوحيد لله تعالى بجميع أقسامه المتقدّمة، وألّا مدبّر في عالم الإمكان إلّا الله تعالى (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ) [11].
وكلّ ما يجري في الكون هو بأمره وعلمه تعالى، فقد دبّر الأشياء وربط الأسباب بمسبّباتها: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ)[12].
لكنّ هذا المعنى لا ينافي أن يأذن الله تعالى لأحد خلقة بتدبير أمر ما، وهو لا ينافي التوحيد؛ لأنّ التدبير حقيقةً راجع إلى الله تعالى وليس للمأذون له والموكّل في الأمر، يقول تعالى: (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ)[13]، فالآية صريحة في نسبة الوفاة إلى ملك الموت، لكنّ هذا لا ينافي التوحيد الأفعالي بأنّ الله تعالى هو الذي يتوفّى الأنفس، كما قال تعالى: (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)[14].
وكذلك وجود مدبّرات في الكون لا ينافي التوحيد، كما في الآية: (فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا)[15] التي فُسّرت بالملائكة الذين يدبّرون شؤون العالم بأمر الله، والذين لا يتخلّفون ولو لحظة واحدة في تنفيذ ما يؤمرون به[16]، فتقوم هذه المدبّرات بالوظائف بإذن الله تعالى، وهي بذلك تكون مظهراً من مظاهر قدرة الله تعالى ووحدانيّته.
ثمّ إنّ الأنبياء والرسل والأئمّة^ يمثّلون خلافة الله في الأرض، وهم أفضل مَن مثّل التوحيد لله تعالى ودعوا الناس إليه، وكانوا وجه الله وبابه الذي منه يؤتى، كما ورد في دعاء الندبة: «أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجّه الأولياء؟»[17]. فكانوا^ مظهراً من مظاهر التوحيد لله تعالى، والمذكّرين به والداعين إليه.
وقد ورد عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله× في قول الله: (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) [18]، قال: «نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملاً إلّا بمعرفتنا»[19].
وعن حنان بن سدير في رواية طويلة عن أبي عبد الله الصادق× أنّه قال: «... وله الأسماء الحسنى التي لا يُسمّى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب فقال: (فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ)[20] جهلاً بغير علم، فالذي يُلحد في أسمائه بغير علم يُشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظنّ أنّه يُحسن، فلذلك قال: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ)[21]، فهم الذين يُلحدون في أسمائه بغير علم فيضعونها غير مواضعها. يا حنان، إنّ الله تبارك وتعالى أمر أن يتّخذ قوم أولياء، فهم الذين أعطاهم الله الفضل وخصّهم بما لم يخصّ به غيرهم، فأرسل محمّداً | فكان الدليل على الله بأذن الله} حتى مضى دليلاً هادياً، فقام من بعده وصيّه× دليلاً هادياً على ما كان هو دلّ عليه من أمر ربّه من ظاهر علمه، ثمّ الأئمّة الراشدون^»[22].
وكذلك تناولت نصوص زيارة الإمام الحسين× عقيدة التوحيد؛ حيث وردت عن المعصوم× في زيارة الحسين× نصوص واضحة وجلّية في ذلك، كما عبّرت تلك النصوص الشريفة عن السلوكيّات والمواقف التي جسّدها أبو عبد الله× وأهل بيته وأصحابه التي ترتبط بعقيدة التوحيد، ومنها الإقرار لله تعالى بالوحدانية، وهو مفهوم عقائدي مرتبط بـ(العقل النظري)، ويلازمه ما ينبغي أن يُعمل وفقه، كما يُسمّى بـ(العقل العملي)، فقول: لا إله إلّا الله الذي هو شعار التوحيد تلازمه العبودية المحضة لله، والإخلاص لله تعالى، والخشية من الله، والصبر في جنب الله، والرضا والتسليم لله، والحبّ والبغض في الله، والدعوة إلى الله، والتوجّه إلى الله، والجهاد في سبيل الله، والصبر في جنب الله، والفناء في الله، والاحتساب لله، والتوكّل على الله، والبذل في سبيل الله، و... هكذا هي المفاهيم المرتبطة بعقيدة التوحيد التي جسّدها الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه، والتي نصّ عليها الإمام المعصوم في الزيارة، ومن ذلك: «أشهد أنّك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين»[23].
فمن خلال ما تقدّم تظهر أهمّية البحث من إبراز مظاهر التوحيد التي تضمنتها نصوص الزيارة التي زار بها المعصوم جدّه الحسين×، وشهد له ولأهل بيته وأصحابه فيها بتجسيد تلك المظاهر التوحيدية. وهذا ما يحدّد نطاق البحث؛ حيث سنقتصر فيه على نصوص الزيارة، فنذكر ما يسع المقام ذكره من مظاهر التوحيد والصفات والأسماء الجلالية والجمالية المرتبطة بعقيدة التوحيد، مستدلّين على ذلك بسيرة ومواقف وسلوك رجال كربلاء، التي تضمنتها نصوص الزيارة.
نعم، يمكن من خلال التأمّل والتدبّر في نصوص الزيارة الوصول إلى أكثر ممّا أشرنا إليه في بحثنا بكثير، لكنّنا نكتفي بما يناسب المقام؛ لذلك نُشير إلى بعض تلك المظاهر، وهي كما يلي:
1ـ مظهر خلافة الله في الأرض
جعل الله تعالى خليفةً له في الأرض كما أشار إليه القرآن الكريم: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) [24]، وحيث إنّ الخليفة لا بدّ أن يكون حاكياً عن المستخلِف، متّصفاً بصفاته، متخلّقاً بأخلاقه، يحمل من الصفات ما يُصيّره مؤهّلاً لهذا الجعل الإلهي والاختيار الربّاني لكي يكون خليفةً.
فاختيار الله تعالى لهذا الشخص المعيّن ليكون خليفةً له وحاكماً باسمه في الأرض، خاضع لعلمه تعالى في شؤون الخلق، ومَن منهم مناسب للخلافة الإلهية في الأرض، فالخلافة غير مقصورة على شخص آدم× فقط، بل كذلك تسري إلى بنيه، فيُشاركونه فيها من غير اختصاص.
كما أنّها مستمرّة إلى يوم القيامة في الأنبياء والأوصياء، فهم خلفاء الله في الأرض، وأفضل الأنبياء أُولي العزم، وأفضلهم خاتم النبيّين محمّد‘[25]، ثمّ الأئمّة الأطهار^ نفس النبي لا فرق بينهم وبينه إلّا النبوّة، فهم خلفاء الله في الأرض، ولا تخلو الأرض من خليفة له تعالى؛ فإنّ الجعل الإلهي للخلافة مستمرّ.
ومن هنا؛ يتّضح ما ورد في نصوص زيارة الإمام الحسين×: «السلام عليك يا وارث آدام صفوة الله …»؛ حيث امتدّت وراثة الإمام الحسين× للأنبياء^ من النبي آدام× سبباً، ونسباً إلى النبي الخاتم محمّد‘، مروراً بإبراهيم الخليل× حامل لواء التوحيد وابنه إسماعيل ذبيح الله×[26]، بل وارث لجميع الأنبياء والرسل الذين قدّموا أنفسهم قرابين على مذبح التوحيد الذي دعوا إليه، ودافعوا عنه بكلّ وسعهم.
وكان الأئمّة الأطهار امتداداً لتلك الرسالة، وكما ورد في نصوص (نهج البلاغة) من كتاب له× في جواب معاوية: «وكتاب الله يجمع لنا ما شذّ عنّا، وهو قوله سبحانه: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)[27]، وقوله تعالى: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ)[28]. فنحن مرّة أولَى بالقرابة، وتارة أولَى بالطاعة»[29].
و«عن مثنّى الحنّاط، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر× فقلت له: أنتم ورثة رسول الله‘؟ قال: نعم. قلت: رسول الله‘ وارث الأنبياء، علم كلّ ما علموا؟ قال لي: نعم. قلت: فأنتم تقدرون على أن تُحيوا الموتى وتبرئوا الأكمه والأبرص؟ قال: نعم بإذن الله…»[30].
فالإمام× يحمل على عاتقه إحياء سنّة الأنبياء والرسل في إقامة التوحيد، وإحياء الدين وإقامة الحقّ، فيؤدّي× الدور الذي أدّاه الأنبياء في الصراع مع الطغاة وسلاطين الجور، وهو صراع مستمرّ على مرّ العصور وتوالي الأيّام والدهور، وهو في الحقيقة صراع بين الحقّ والباطل، بين الموت والحياة، فالتوحيد يمثّل الحياة للفرد والمجتمع، بينما الاتّجاه الآخر الذي يتمثّل بالكفر أو الانحراف عن الحقّ يمثّل الموت كما ورد عن الإمام علي×: «لا حياة إلّا بالدين، ولا موت إلّا بجحود اليقين، فاشربوا العذب الفرات، ينبّهكم من نومة السبات، وإيّاكم والسمائم المهلكات»[31]. وعنه× أيضاً: «التوحيد حياة النفس»[32].
وهذا هو المنطق القرآني الذي سعى الإمام الحسين× إلى تحقيقه من خلال خلافته لله تعالى في الأرض ووراثته للأنبياء^، من أجل إحياء النفوس بالتوحيد لله تعالى؛ فإنّ المنطق القرآني يعتبر غير التوحيد هو الموت والهلاك، الذي يتمثّل بالكفر والانحراف اللذين واجههما الأنبياء من قبل، قال تعالى: (لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ)[33].
ومن خلال ذلك يتّضح فيما ورد من نصوص زيارة الإمام الحسين× أنّه× الامتداد الطبيعي في حمل لواء التوحيد الذي حمله الأنبياء^، فنذكر بعض الفقرات التي وردت في نصوص الزيارة، ومنها:
١ـ «السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي، السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله»[34].
2ـ «وأشهد أنّ الجهاد معك، وأنّ الحقّ معك وإليك، وأنت أهله ومعدنه، وميراث النبوّة عندك وعند أهل بيتك صلّى الله عليك وسلّم تسليماً، أشهد أنّك صدِّيق الله وحجّته على خلقه»[35].
3ـ «أشهد أنّك حجّة الله وابن حجّته، وأشهد أنّك قتيل الله وابن قتيله، وأشهد أنّك ثار الله في الأرض وابن ثاره، وأشهد أنّك وتر الله الموتور في السماوات والأرض، أشهد أنّك صدّيق عند الله وحجّته على خلقه»[36].
2ـ مظهر الدعوة إلى الله
يمثّل الإمام الحسين× الامتداد الطبيعي في الدعوة إلى الله تعالى، وشريعة جدّه المصطفى‘، وهو المتحدّث باسم الله والناطق بحجّته والداعي إلى الله؛ فإنّ أيّة دعوة لا بدّ لها من أنصار ومتحدّث باسمها، ينصرونها ويبذلون الغالي والنفيس دونها بدون أدنى تردّد، وعلى مرّ التاريخ كان ذلك واضحاً كما صرّح بذلك القرآن الكريم: (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)[37].
فنصرة الله تعالى والدعوة إليه مناطة بأشخاص لبّوا هذه الدعوة، وكانوا السابقين لها، وهذا ما كان واضحاً في النصوص التي وردت في زيارته×، نذكر منها:
«لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني فقد أجابك قلبي وشعري وبشري ورأيي وهواي، على التسليم لخلف النبي المرسل، والسبط المنتجب، والدليل العالم، والأمين المستخزن، والموصي البليغ، والمظلوم المهتضم. جئت انقطاعاً إليك وإلى ولدك وولد ولدك، الخلف من بعدك على بركة الحقّ»[38].
«أشهد أنّك قد بلّغت ما أُمرت به، وقمت بحقّه، وصدّقت مَن قبلك، غير واهن ولا موهن، صلّى الله عليك وسلّم تسليماً، فجزاك الله من صدّيق خيراً عن رعيّتك. السلام عليك يا أمين الله، وحجّة الله، وباب الله، والدليل على الله، والداعي إلى الله، أشهد أنّك قد حلّلت حلال الله وحرّمت حرام الله، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، ودعوت إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة»[39].
«أشهد أنّك قد بلّغت عن الله ما أُمرت به، ووفيت بعهد الله، وتمّت بك كلماته، وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين، ولعن الله أُمّةً قتلتك»[40].
3ـ مظهر البيّنة من أمر الله والثبات عليه
إنّ الصراع الدائر بين الحقّ والباطل في بعض الأحيان يشوبه الريب، خصوصاً إذا كان اتّجاه العقل الجمعي خلاف الحقّ، أو على الأقلّ التردّد وعدم حسم الأمر في الركون إلى جهة ما، لكنّ رجال النهضة الحسينية كانوا على بصيرة من أمرهم، لم يعتريهم الشكّ والريب ولا قيد أُنملة، فنهضتهم قائمة على أُسس ومبادئ صلبة، مستندة إلى أركان ثابتة، ولم تكن مجرّد انفعال أو ردة فعل لحادثة ما، وإنّما كانت قضية مبدأ وثبات على أساس العلم والتفكّر، فلا يمكن أن يتحقّق الهدف المنشود بدون أن تكون هناك معرفة وقاعدة علمية ثابتة يتّكئ عليها المبدأ، كما لا بدّ أن يكون القائم بتلك القضية مؤمناً إيماناً راسخاً وثابتاً على قضيّته.
وقد تجلّى ذلك الرسوخ والثبات على القضية الحقّة في الإمام الحسين× وأصحابه، فقد كانت لديهم ركيزة ثابتة ومستقرّة فكرية وعلمية، فقد كانوا على بيّنة من أمرهم، فأصبحوا ميزاناً للحقّ، ولم يقتصر الأمر على كونهم قدوةً للآخرين في السير على خطاهم، بل كانوا هم أنفسهم طريق الحقّ وميزان العمل، كما ورد في زيارة أمير المؤمنين×: «السلام على أبي الأئمّة، وخليل النبوّة، والمخصوص بالإخوّة. السلام على يعسوب الإيمان، وميزان الأعمال، وسيف ذي الجلال»[41].
وقد أرسى الإمام الحسين× بنهضته قاعدة كلية فكرية عقائدية لجميع الناس؛ وذلك قوله في الاعتراض على خلافة يزيد (لعنه الله) بما نصّه: «مثلي لا يُبايع مثله، وعلى الإسلام السلام إذا قد بُليت الأُمّة براعٍ مثل يزيد»[42].
فكان× لا يخشى في قول الحقّ عاقبة المواجهة لأعلى سلطة دنيوية ودينية مستندة إلى وعّاظ السلاطين؛ لأنّ القبول بذلك يعني القبول بالتوحيد المزيّف، وبالتالي يضيع التوحيد الحقيقي لله تعالى؛ وبذلك فقد أسّس× مبدأ رفض طاعة الحاكم الجائر.
وعليه؛ فصاحب القضية يجب أن يكون على بيّنة وثبات من أمره، وأن يقوم بقضيّته بإيمان راسخ بالمبادئ الحقّة؛ ومن خلال ذلك يتّضح ما ورد من نصوص في زيارة الإمام الحسين× تناولت هذا المعنى، نذكر منها ما يلي:
«وأشهد أنّك كنت على بيّنة من ربّك، بلّغت ما أُمرت به، وقمت بحقّه، وصدّقت مَن كان قبلك، غير واهن ولا موهن»[43].
«أشهد أنّك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته»[44].
ما خاطب به الإمام الصادق× عمّه أبا الفضل العبّاس بن علي’ قائلاً: «أشهد أنّك لم تهن ولم تنكل، وأنّك مضيت على بصيرة من أمرك»[45].
كما روي أنّه× قال: «كان عمّي العبّاس بن علي× نافذ البصيرة، صُلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسين وأبلى بلاءً حسناً، ومضى شهيداً»[46].
4ـ مظهر الشوق إلى لقاء الله والزهد في الدنيا
من أهمّ الدروس والعِبَر التي يمكن استخلاصها من كربلاء والنصوص التي وردت في زيارة الإمام الحسين× وشهداء كربلاء، هو الزهد في الدنيا، وهذا الأمر يُعدّ شرطاً في الجهاد؛ فإنّ الانصراف عن الدنيا وملذّاتها والتوجّه إلى الله تعالى وتوحيده، يبثّ روح الشوق للقاء الله}، ولا يتحقّق ذلك إلّا بترك الدنيا كما ورد عنهم ^: «طلاق الدنيا مهر الجنّة»[47].
وهذا ما جسّده عملياً شهداء كربلاء؛ حيث طلّقوا الدنيا التي كان بإمكانهم الميل لها؛ حيث كانت الظروف مهيّأةً لهم، فلو قبلوا بالمغريات التي قدّمها لهم أُمراء الكوفة لأقبلت عليهم الدنيا، لكنّهم اختاروا لقاء الله تعالى، وسلّموا أمرهم له.
وهذا المشهد الراقي يجسّد رؤية الإمام الحسين× للموت، وأنَّه وصل وليس بفصل، فهو لقاء الله؛ وذلك قوله×: «مَن كان فينا باذلاً مهجته، موطِّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا»[48]. فاختار لقاء الله تعالى مهما كانت النتيجة الدنيوية من القتل والتمثيل بجسده الشريف، فهذا يُعدّ مظهراً من مظاهر التوحيد والإخلاص في العبودية لله تعالى، ويُعدّ من الكفر بأصنام الهوى والجاه والشهرة؛ فإنّها أصنام كذلك لكنّها لا تُرى كالأصنام المادّية الكثيفة المصنوعة من الحجارة وغيرها.
من هنا؛ نرى أنّ الإمام الصادق× يصف عمّه العبّاس في نصّ الزيارة قائلاً: «... المجيب إلى طاعة ربِّه، الراغب فيما زهد غيره، من الثواب الجزيل والثناء الجميل»[49]، حيث إنّ أبا الفضل العبّاس× ترك الدنيا التي عُرضت عليه، ورغب في الآخرة وثوابها الجزيل، وهذا هو شرط الجهاد، فلا يتحقّق الجهاد ما لم يتحقّق شرطه، وهو ترك الدنيا.
فترك الدينا ومغرياتها وعشق الآخرة والشوق للقاء الله تعالى دليل على ذلك العشق الإلهي الذي جسّده شهداء كربلاء، وقد أشار إلى ذلك أمير المؤمنين×، فقد روي عن الإمام الباقر× أنّه قال: «خرج علي يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل، تقدّم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال لها: المقدفان، فقال: قُتل فيها مائتا نبي ومائتا سبط كلّهم شهداء، ومناخ ركاب ومصارع عشّاق شهداء، لا يسبقهم مَن كان قبلهم، ولا يلحقهم من بعدهم»[50].
هؤلاء الشهداء الربّانيون عشقوا الشهادة ولقاء الله تعالى، وزهدوا في الدنيا وملذّاتها، فخاطبهم الإمام المعصوم× قائلاً: «السلام عليكم أيّها الربّانيون، أنتم لنا فرط وسلف، ونحن لكم أتباع وأنصار. أشهد أنّكم أنصار الله كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ)»[51]، فما وهنتم وما ضعفتم وما استكنتم حتى لقيتم الله على سبيل الحقّ، ونصرة كلمة الله التامّة، صلّى الله على أرواحكم وأبدانكم وسلّم تسليماً. أبشروا بموعد الله الذي لا خلف له، إنّه لا يُخلف الميعاد، الله مدرك لكم ثار ما وعدكم، أنتم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة، أنتم السابقون والمهاجرون والأنصار، أشهد أنّكم قد جاهدتم في سبيل الله، وقتلتم على منهاج رسول الله|، الحمد لله الذي صدقكم وعده وأراكم ما تُحبّون»[52].
5ـ مظهر الصبر في جنب الله والاحتساب لأمر الله
لم تكن واقعة كربلاء حادثةً حصلت في غابر الأيّام وتوالي الدهور والأعوام، بل واقعة عظيمة احتوت دروساً وعِبَر ومظاهر توحيدية عبادية لله} بصورة منقطعة النظير، فهي عصيّة عن المماثلة والتكرار والنظير كما ورد: «لا يوم كيومك يا أبا عبد الله»[53].
وهذا إنّما يدلّ على واحدية الواقعة على مرّ العصور، فلا يوجد لها نظير على جميع المستويات، وقد ضُرب فيها أروع المثل العليا للتوحيد والطاعة والتسليم لله تعالى، والصبر على القضاء بالرغم من هول المصيبة، وتمثّل ذلك بدعائه× عندما ضجّت عليه الخيل وتكاثر عليه الرجال، و«بقي× ثلاث ساعات من النهار ملطّخاً بدمه، رامقاً بطرفه إلى السماء، وينادي: يا إلهي، صبراً على قضائك، ولا معبود سواك، يا غياث المستغيثين»[54]. فسلّم أيّما تسليم لله تعالى ما دام أنّ ذلك بعين الله تعالى؛ ولذلك قال×: «هوّن ما نزل بي أنّه بعين الله تعالى»[55].
وقال× أيضاً: «صبراً على قضائك يا ربّ، لا إله سواك، يا غياث المستغيثين، ما لي ربّ سواك، ولا معبود غيرك، صبراً على حكمك، يا غياث مَن لا غياث له، يا دائماً لا نفاد له، يا محيي الموتى، يا قائماً على كلّ نفس بما كسبت، احكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين»[56].
والمتمعّن في تلك النصوص يجد عظم الصبر والثبات الذي جسّده الإمام الحسين×، ففي أحلك الظروف وأشدّ اللحظات يضرب أروع الأمثلة في الصبر على الأذى في جنب الله تعالى، والتسليم لله تعالى تسليماً مطلقاً ما دام أنّ تلك المصائب في عين الله تعالى، كلّ ذلك امتثالاً لطاعته تعالى وعبوديّته وتوحيده والشعور بالنعمة من خلال الشكر والحمد له تعالى، وذلك في أقسى المواقف إيلاماً وأشدّ الأوقات عصيبة.
وهذا الأمر من أروع مظاهر التوحيد التي جسّدتها واقعة كربلاء المنقطعة النظير، فلا يمكن أن يأتي بها الدهر وتكرّرها الأيّام، لذلك جاء في نصوص زيارته× هذا المعنى، ومنها:
«اللّهمّ إنّي أشهد أنّه قد بلّغ عن رسولك ما حُمّل، ورعى ما استُحفظ، وحفظ ما استُودع، وحلّل حلالك وحرّم حرامك، وأقام أحكامك وجاهد الناكثين في سبيلك، والقاسطين في حكمك، والمارقين عن أمرك، صابراً محتسباً لا تأخذه فيك لومة لائم»[57].
«السلام عليك يا أبا عبد الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ما أعظم مصيبتك عند أبيك رسول الله، وما أعظم مصيبتك عند مَن عرف الله}، وأجلّ مصيبتك عند الملأ الأعلى، وعند أنبياء الله، وعند رسل الله. السلام منّي إليك والتحية مع عظيم الرزية»[58].
«مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيّتها في الإسلام، وفي جميع أهل السماوات والأرض»[59].
٦ـ مظهر الخشية من الله تعالى
قد يقوم بعض الأشخاص من أجل تحقيق أهداف معيّنة بقضايا تكون محقّةً أحياناً، وأحياناً أُخرى ليست كذلك، وذلك بحسب ما يمتلكه قادة القضية من صفات ومؤهّلات، ولكن ما يُميّز القادة الربّانيّون هو التقوى والخشية من الله تعالى، ومن أُولئك القادة الإمام المعصوم، فهو يمثّل أقصى مراتب الورع والخشية من الله تعالى، فقد روي عن أمير المؤمنين× في بعض فقرات (دعاء الصباح) أنّه قال: «مَن ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومَن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك»[60].
من مفهوم هذه الفقرة المتقدّمة نلاحظ أنّ المعصية نقص في المعرفة والعلم، والخوف من الله وحده مظهراً من مظاهر التوحيد له تعالى والإقرار بالعبودية والطاعة، يقول تعالى: (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ)[61]؛ لذلك فإنّ القادة الربّانيّين لا يخشون أحداً إلّا الله تعالى، فلم يثنهم الترهيب والتخويف عن أداء مهامّهم، وواجهوا ذلك أشدّ المواجهة بعزيمة وإصرار وثبات، فلا يهابون السلطان وسطوته، ولا يأبون الطاغي وزبانيّته، بل يواجهونهم مباشرة حتّى في دواوينهم وأمام حاشيتهم، ومن ذلك قول سيّد الشهداء× للوليد بن عتبة عندما أراد أن يأخذ منه البيعة ليزيد، فقال×: «... ويزيد رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل النفس المحرّمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يُبايع مثله»[62].
فالخشية عند الربّانيّين الموحّدين تعني الخوف من الله تعالى الحاضر عندهم، والشاهد على جميع أفعالهم، والمراقب لجميع شؤونهم وأحوالهم، لا كما يتصوّر غيرهم من غياب الله تعالى، فيرتكب المعاصي في الخلوات؛ لتصوره بأن لا أحد يُشاهده، متناسياً الله تعالى الشاهد على جميع خلقه.
وقد ورد عن أمير المؤمنين× محذراً من ذلك: «اتّقوا معاصي الله في الخلوات؛ فإنّ الشاهد هو الحاكم»[63]، فربّما تكون المحاكمة في الدينا مختلفة عن ذلك؛ حيث إنّ الشاهد الذي شهد ارتكاب الجرم غير الحاكم الذي يُحاكم المتّهم على جرمه، لكنّ الحال يختلف في العالم الآخر يوم القيامة فالشاهد هو نفس الحاكم، وهو الله تعالى، بل الأمر يكون أشدّ عندما تشهد أعضاء الجسم كاليد والرجل أيضاً، كما أشار إلى هذا المعنى القرآن الكريم، وذلك قوله تعالى: (الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ)[64].
فالقائد الربّاني لا يخاف إلّا من الله تعالى؛ ولذلك يقف بوجه أعداء الدين بكلّ شجاعة، ويضحّي بالغالي والنفيس في سبيل الحقّ تعالى، وقد أشارت إلى هذا المعنى جملة من نصوص زيارات الإمام الحسين×، نذكر منها:
«أشهد أنّك قد بلّغت عن الله ما أمرك به ولم تخشَ أحداً غيره، وجاهدت في سبيله، وعبدته مخلصاً حتى أتاك اليقين»[65].
«اللّهمّ إنّي أشهد أنّه قد بلّغ عن رسولك ما حُمِّل، ورعى ما استُحفظ، وحفظ ما استُودع، وحلّل حلالك، وحرّم حرامك، وأقام أحكامك، وجاهد الناكثين في سبيلك، والقاسطين في حكمك، والمارقين عن أمرك، صابراً محتسباً لا تأخذه فيك لومة لائم»[66].
٧ـ مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
من أهمّ مهامّ خلفاء الله في الأرض من الأنبياء والأئمّة^، بل جميع المبلّغين لدين الله تعالى، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو من الفرائض الجماعية وأهمّ الواجبات الدينية التي أُنيطت بالإنسان، والغاية منه هداية الناس إلى الله تعالى؛ لذلك يسعى الأنبياء والرسل والأئمّة إلى توجيه الفرد والمجتمع نحو الصلاح والإصلاح، فلم يدّخروا وسعاً ولم يألوا جهداً في هذا السبيل، حتى دفعوا أرواحهم وكلّ ما يملكون ثمناً لذلك، فكان كلّ وجودهم لله تعالى، قال: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)[67].
وانطلاقاً من هذه الفريضة؛ فقد قام الأنبياء والأوصياء بالدفاع عن عقيدة التوحيد في صراعهم مع الكفّار والمنحرفين عن طريق الحقّ؛ ليحملوا الناس على السير في الاتّجاه الصحيح الذي رسمه الله تعالى بحكمته لإدارة شؤون الخلق ومصالحهم بما يُناسب حالهم وصلاحهم، كما صرّح بذلك الإمام الحسين× في وصيّته لأخيه محمد بن الحنفية (رضوان الله عليه)، حيث جاء فيها: «... وأنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي|، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب×»[68].
فكان× طالباً للإصلاح وهداية الناس، بينما كان غيره يعمل على صدّ الناس عن الله تعالى، وقطع طريق الهداية أمامهم؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف ومصالح شخصية، وهذا هو المتعارف من سيرة الأُمراء والملوك وطلّاب السلطة، فدائماً ما يسعون إلى السيطرة على الحكم والتحكّم بمصير الناس ومصالحهم، يقول تعالى: (وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ)[69].
فهؤلاء السلاطين يضعون العراقيل والعوائق أمام المصلحين، فيتصدّى لهم الأنبياء والأولياء، ويبذلون في سبيل ذلك أرواحهم بكلّ إخلاص وتفانٍ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) [70].
إذاً؛ مواجهة سيّد الشهداء× كانت من هذا النوع، كما كان× مراعياً في دعوته إلى الله مسألة التدرّج، فلم يلجأ× إلى السلاح إلّا بعد نفاد طريق الموعظة الحسنة، والدفع بالتي هي أحسن، وهذا هو المنطق القرآني في الدعوة الحقّة، يقول تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ)[71].
لكنّ هذا الدين نفسه وهذا المنطق القرآني أيضاً يأمران بالغلظة والشدّة في بعض الأحيان، وذلك عندما لا ينفع اللين والموعظة الحسنة.
إذاً؛ ففي المرتبة الأُولى لا بدّ أن تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم تنفع يُنتَقل إلى المرتبة الثانية، وهي الشدّة والغلظة، يقول تعالى: (وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)[72]. فالترتّب في أُسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان مظهراً توحيديّاً يُعبّر عن أمر الله تعالى، الأمر الذي تجسّد في كربلاء، فقد تناولت بعض نصوص الزيارات هذا المعنى، ومنها:
«أشهد أنّك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، واتّبعت الرسول، وتلوت الكتاب حقّ تلاوته»[73].
«أشهد أنّك قد أقمتَ الصلاة وآتيتَ الزكاة، وأمرتَ بالمعروف ونهيتَ عن المنكر، وعبدتَ الله مخلصاً حتى أتاك اليقين»[74].
«أشهد أنّك قد أقمتَ الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرتَ بالمعروف ونهيتَ عن المنكر، ودعوتَ إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة»[75].
«اللّهمّ إنّي أشهد أنّه قد بلّغ عن رسولك ما حُمّل، ورعى ما استُحفظ، وحفظ ما استُودع، وحلّل حلالك وحرّم حرامك، وأقام أحكامك، وجاهد الناكثين في سبيلك، والقاسطين في حكمك، والمارقين عن أمرك، صابراً محتسباً لا تأخذه فيك لومة لائم»[76].
٨ـ مظهر الحاكمية لله
من مظاهر التوحيد التي وردت في نصوص زيارة الإمام الحسين× الإقرار بأنّ الحاكمية المطلقة لله تعالى، وهو من أهمّ المظاهر التوحيدية التي جسّدتها كربلاء، لذلك نقرأ في بعض نصوص الزيارة: «وأشهد أنّ دعوتك حقّ، وكلّ داعٍ منصوب غيرك فهو باطل مدحوض، وأشهد أنّ الله هو الحقّ المبين»[77].
فإنّ المنصب الإلهي لا يتمّ بالقهر والقوّة والغلبة، وإنّما يكون من خلال النصّ؛ فإنّ إقامة الحقّ هي الغاية من المنصب، وليس هو المقصود لذاته؛ فإنّ ذلك لا يساوي عند أهل البيت «عفطة عنز»[78]. ما لم يكن هناك عدل ومساواة.
وعليه؛ لا يُمكن التحكّم بمصير البلاد والعباد ما لم يكن الحاكم مُنَصّباً من قبل الله تعالى، فلا يتمّ التنصيب من خلال الوسائل الأُخرى، مثل الاجتهاد أو القوّة أو انتخاب الناس، بل هو مختصّ بالله تعالى.
وقد واجهه رسول الله‘ هذا الأمر من المشركين عندما اعترضوا على اختياره رسولاً من قبل الله تعالى: (وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ)[79]، فجاء الردّ القرآني بأنّ هذا المنصب مجعول من قبل الله تعالى، وهو يختار مَن يُنصّبه إماماً للناس وهادياً لهم، وذلك قوله تعالى: (اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ)[80].
ومن هنا؛ كان الإمام علي رافضاً لمسألة الشورى؛ ولذلك لم يبايع، وهكذا الزهراء’ حيث احتجّت على القوم بأنّ المنصب والحكم لا يكون لغير مَن نصّبه الله تعالى، وكذلك الإمام الحسين×، فقد جسّد ذلك الأمر ورفض البيعة للظالمين؛ باعتباره الامتداد الطبيعي للرسالة، فأعلن رفضه للنهج الذي أراده أعداء الإسلام من خلال مقولته المشهورة: «مثلي لا يبايع مثله»[81].
٩ـ مظهر الإخلاص لله تعالى
الإخلاص لله في الأفعال غاية التوحيد، وأعلى مراتب العبادة أن يكون العمل لله تعالى خالياً من الشوائب، يقول تعالى: (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ)[82]. كما أنّ الإخلاص يُعبّر عن حالة الإيمان وعمقه والتمحّض في العبودية لله تعالى وتوحيده، والغاية منه وجه الله تعالى ورضاه؛ فانّ قيمة أي عمل بقدر ما فيه من نسبة الإخلاص لله تعالى.
وأهمّ ما تميّزت به كربلاء هو الإخلاص لله تعالى والاستغراق في ذاته وقصد وجهه والتضحية في سبيله، فقد بذل سيّد الشهداء× مهجته لأجل الله تعالى وتعظيماً له وتوحيداً لذاته، لا لأجل مصلحة خاصّة أو منصب معيّن كما يصوّره البعض من أنّه× خرج لأجل الدنيا والسلطة، بل كان خروجه لأجل الله تعالى وإخلاصاً له. كما لم يكن جهاده× رغبةً بالجنّة أو خوفاً من النار، وإنّما كان جهاده في ذات الله ولنيل مرضاته، وهو تجسيد لقوله تعالى: (وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)[83]؛ حيث «إنّ المراد بالرهبة ما هي رهبة إجلال ومهابة، لا ما هي رهبة موآخذة وعذاب»[84].
وعليه؛ فإن كان هناك شيء يجب أن يُبذل فيجب أن يكون لله تعالى، وهذا هو المعنى الذي أراده الحسين× ممّن كان يُريد نصرته والالتحاق بركبه، فقال×: «مَن كان باذلاً فينا مهجته، وموطِّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا، فإنّني راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى»[85]. ولذلك كان أنصاره× نِعمَ الأنصار؛ حيث بذلوا ما بوسعهم في سبيل الحقّ ولقاء الله}، حتّى قال عنهم سيّد الشهداء×: «... يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل إلى محالب أُمّه»[86].
وهذا المقدار من الشوق والإخلاص والانشداد إلى الله تعالى والإيثار بالمال والنفس، وبذل جميع ما يتعلّق بها من الأُمور الدنيوية في سبيل الوصول إلى الله تعالى، نجده متجسّداً في شهداء كربلاء، فكانوا كما قال أمير المؤمنين×: «عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم»[87].
وكما ورد في الصحيفة السجّادية: «واطمأنّت بالرجوع إلى ربّ الأرباب أنفسهم، وتيقّنت بالفوز والفلاح أرواحهم، وقرّت بالنظر إلى محبوبهم أعينهم»[88].
فإنّ هذه الدرجة من الشوق إلى لقاء الله تعالى تجعل الإنسان يُضحّي بكلّ ما يملك في سبيله تعالى.
ومن نصوص الزيارة الواردة في هذا المعنى نذكر ما يلي:
«وأشهد أنّك قد بلّغت ونصحت ووفيت ووافيت وجاهدت في سبيل ربّك، ومضيت للذي كنت عليه شهيداً ومستشهداً، وشاهداً ومشهوداً»[89].
«وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة، والعمى والشكّ والارتياب، إلى باب الهدى من الردى»[90].
«صلّى الله عليك، أشهد أنّك عبد الله وأمينه، بلّغت ناصحاً وأدّيت أميناً، وقلت صادقاً، وقُتلت صدّيقاً، ومضيت على يقين، لم تؤثر عمىً على هدىً، ولم تمل من حقّ إلى باطل، ولم تجب إلّا الله وحده»[91].
١٠ـ مظهر رحمة الله الواسعة
إنّ الرحمة والمحبّة والسماحة من المزايا التي يتّصف بها إمام الأُمّة، فهو يجمع بين عدّة فضائل ومزايا في وقت واحد، ولا تتزاحم تلك الفضائل والمزايا بعضها مع البعض الآخر، بل يصبح الإمام مجمعاً للفضائل والمزايا الإلهية، ويكون مصداقاً لأخلاق الله تعالى، كما ورد: «تخلّقوا بأخلاق الله»[92]، وهذا ما كان عليه أئمّة أهل البيت×.
هذا من جهة، ومن جهة أُخرى هناك جنبة من الصلابة والقوّة والمقاومة والشجاعة والثبات، ممّا لا تقبل المساومة بأغلى الأثمان حتى لو بلغت التضحية أن يُقطّع الشخص هو وعياله ويمثّل بأجسادهم الطاهرة، وهذا ما تحقّق فعلاً بالنسبة لشهداء كربلاء.
وكما أنّ الرحمة والسماحة من مظاهر التوحيد، فكذلك الغضب والشدّة في الله تعالى؛ فليس هناك دافع لدى القادة الربّانيّين غير الله تعالى، فهم يرضون لرضا لله تعالى ويغضبون لغضبه. وليس معنىً لتلك الصلابة والقوّة والغضب الإلهي إلّا لأجل الحياة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في قوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)[93]، وحاصله: إنّ العفو ولو كان فيه ما فيه من التخفيف والرحمة، لكنّ المصلحة العامّة قائمة بالقصاص؛ فإنّ الحياة لا يضمنها إلّا القصاص[94].
فالشدّة والصلابة عند القائد الربّاني متأخّرة عن الرحمة والرقّة والشفقة؛ فإنّ الرحمة إمام والصلابة والغلظة تابع لها ومأموم، وأولياء الله تعالى تسبق رحمتهم غضبهم، والنتيجة: أنّ دأبهم محبّة الآخرين والنصح لهم.
ومن هنا؛ نقرأ في نصوص الزيارة: «وأشهد أنّك قد بلّغت ونصحت ووفيت، وجاهدت في سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة، ومضيت للذي كنت عليه شهيداً ومستشهداً ومشهوداً، فصلّى الله عليك وسلّم تسليماً»[95].
فدعوة الأنبياء والأولياء بالحكمة والموعظة الحسنة واللين والرفق، ولا يلجؤون إلى السلاح مهما أمكن الدفع بغيره، لذلك نهى الإمام الحسين× أصحابه أن يبدؤوا القوم بالقتال، فقد روي عنه× أنّه قال: «ما كنت لأبدأهم بالقتال»[96]، فقدّم النصح لهم وأبلغ في النصيحة، لكنّ القوم ما استجابوا له، وهكذا فعل أصحابه؛ حيث خطب بعضهم بالقوم ونصحهم، بخلاف المعسكر الآخر الذي كان متعطّشاً للقتال.
وهذا الجمع بين الصفات صفات الرحمة واللين والشفقة، مع صفات القوّة والشدّة والغضب ربّما يتعسّر تحقّقه عند غير هؤلاء القادة الربّانيّين المنصّبين من قِبل الله تعالى خلفاء على أرضه، وحججاً على عباده، ومظهري أسماءه الحسنى.
فالإمام الحسين× كان يمتلك من الروح الشفّافة واللطيفة ما جعله يبكي في جميع المواقف التي صُرع فيها أصاحبه وأهل بيته^، بل وصل الأمر بتلك الروح الكبيرة إلى سلك جميع السُبل من أجل نجاة جيش العدو من الهلكة وسوء العاقبة بسبب ما أقدموا عليه، وهذا هو منطق صاحب الرسالة الذي يتمنّى أن يهتدي الجميع إلى الحقّ، ويأسف على مَن يسلك طريق الباطل، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم مخاطباً النبي الأكرم‘ بقوله تعالى: (فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ)[97].
وهذا لا يتنافى مع ما يحمله القائد المنصَّب من روح جهادية وصلابة وشجاعة وقوّة قلب، فهذه الصفات تنسجم تماماً مع الرقّة والخضوع لله تعالى والخشية منه، وهذا ما تجلّى في أدعية الإمام الحسين× في يوم العاشر، فإنّ هذا الخلق القرآني لا يفارق إمام الأُمّة وقائدها، فممّا ورد في زيارة النبي الكريم‘: «وأشهد أنّك قد بلّغت رسالات ربّك، ونصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل الله، وعبدت الله حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة، وأدّيت الذي عليك من الحقّ، وأنّك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، فبلغ الله بك أفضل شرف محلّ المكرمين»[98].
وفي زيارة أمير المؤمنين×: «كنت للمؤمنين أبا رحيماً، إذ صاروا عليك عيالاً، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا، وحفظت ما أضاعوا، ورعيت ما أهملوا، وشمرت إذ اجتمعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ أسرعوا، وأدركت أوتار ما طلبوا، ونالوا بك ما لم يحتسبوا، كنت على الكافرين عذاباً صبّاً ونهباً، وللمؤمنين عمداً وحصناً»[99].
١١ـ مظهر إقامة العبادة لله
إنّ عشق العبادة والتعلّق بها أهمّ ما تميّز به شهداء كربلاء، فقد ضربوا أروع الأمثلة في عشق الصلاة، والدعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تجد أحداً من معسكر الإمام الحسين× إلّا وقد ضُرب به المثل الأعلى في التقوى والعبادة والزهد، فكانوا من العبّاد الزهّاد، وقرّاء القرآن، وفرسان المصر وأبطال الهيجاء، وكانوا علماء حكماء، وفصحاء خطباء، أمثال: حبيب بن مظاهر الأسدي، وبرير بن خضير، ومسلم بن عوسجة. هذه الأسماء ينحني لها التاريخ إعظاماً وإجلالاً.
وكان رجال المعسكر المقابل من أهل الانحراف والفسوق، وشذّاذ الآفاق وأهل الدينا، والمتلونين الذين لا يحملون أيّ مبدأ، منهم: شمر بن ذي الجوشن، وعمر بن سعد، ومحمد بن الأشعث، وأمثالهم ممّن تقطع الأنفاس رائحة تأريخهم النتنة، وتشمئز منها النفوس.
كان همّ الإمام الحسين وأصحابه^ الشاغل هو قضاء الوقت
قبل المعركة ـ
بالصلاة والعبادة والدعاء وقراءة القرآن، كما كانوا يطلبون وقف القتال من أجل
الصلاة، فممّا روي من أحداث ليلة العاشر أنّ الإمام الحسين× قال لأخيه العبّاس×: «ارجع
إليهم، فإن استطعت أن تؤخّرهم إلى غدوة وتدفعهم عند العشية لعلّنا نصلّي لربّنا
الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أنّي قد كنت أُحبّ الصلاة له، وتلاوة كتابه،
[و]كثرة الدعاء والاستغفار»[100].
فكانوا يعشقون العبادة، ويلهجون بذكر الله ودعائه، وقد ورد «عن أبي عبد الله×، قال: قال رسول الله‘: أفضل الناس مَن عشق العبادة فعانقها وأحبّها بقلبه، وباشرها بجسده، وتفرّغ لها، فهو لا يُبالي على ما أصبح من الدنيا على عُسر أم على يُسر»[101].
ومن هذا المنطلق؛ فقد «بات الحسين وأصحابه تلك الليلة [أي: ليلة العاشر من المحرّم]، ولهم دوي كدوي النحل، ما بين راكع وساجد، وقائم وقاعد»[102].وذلك من أجل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ حيث ورد في زيارته× ما نصّه: «أشهد أنّك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله مخلصاً حتى أتاك اليقين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته»[103].
خاتمة البحث
تحصّل ممّا تقدّم أنّ هناك مجموعة من المظاهر التوحيدية يمكن استخلاصها من نصوص زيارات الإمام الحسين×، وهي كالآتي:
مظهر خلافة الله في الأرض، وأنّ الخليفة لا بدّ أن يكون حاكياً عن المستخلِف، ومتّصفاً بصفاته، ومتخلّقاً بأخلاقه، وأن يحمل من الصفات ما يؤهّله لهذا الجعل الإلهي، لذلك كان الأنبياء والأوصياء خلفاء الله في الأرض، وقد أشارت زيارة وارث إلى هذا المعنى.
مظهر الدعوة إلى الله، وأنّ الإمام الحسين× الامتداد الطبيعي للدعوة إلى الله تعالى.
مظهر البيّنة من أمر الله والثبات عليه، الأمر الذي جسّده رجال النهضة الحسينية؛ حيث كانوا على بصيرة من أمرهم، فلم يعتريهم الشكّ والريب.
مظهر الشوق إلى لقاء الله والزهد في الدنيا، وقد تجلّى هذا المعنى في الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه^، وبرز في كلماتهم ومواقفهم البطولية.
مظهر الصبر في جنب الله، الذي جسّده الإمام الحسين× في أحلك الظروف وأشدّ اللحظات، وهو يضرب أروع الأمثلة للصبر على الأذى في جنب الله تعالى؛ امتثالاً لطاعته تعالى وعبوديّته وتوحيده.
مظهر الخشية من الله تعالى، وهو ممّا يتميّز به القادة الربّانيّون عن غيرهم، وهكذا كان الإمام الحسين× لا يخشى أحداً غير الله تعالى، كما أشارت إلى ذلك نصوص الزيارات.
مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنّه من أهمّ مهامّ خلفاء الله في الأرض، وقد جسّد الإمام الحسين× هذا المعنى في نهضته المباركة، وكما نصّت على ذلك مجموعة من فقرات زياراته ×.
مظهر الحاكمية لله تعالى، وهو من مظاهر التوحيد التي وردت في نصوص زيارة الحسين× الذي جسّدته كربلاء؛ فإنّ المنصب والحكم على الناس لا يتمّ بالقهر والقوّة والغلبة، إنّما يكون بالجعل الإلهي والنصّ.
مظهر الإخلاص لله تعالى، وأنّه غاية التوحيد وأعلى مراتب العبادة، وهو ما جسّده الإمام الحسين× وأهل بيته وأصحابه^ في واقعة الطفّ.
مظهر رحمة الله الواسعة، وهي من الصفات التي اتّصف بها الإمام الحسين×، والتي تجلّت في مواقفه يوم عاشوراء، فقد جمع بين صفات الرحمة والشفقة، وصفات الصلابة والقوّة والمقاومة والشجاعة والثبات.
مظهر إقامة العبادة لله تعالى، وأنّ عشق العبادة والتعلّق بها من أهمّ ما تميّز به شهداء كربلاء، فقد ضربوا أروع الأمثلة في إقامة الصلاة، والتهجّد والدعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الممارسات العبادية.
المصادر والمراجع
* القرآن الكريم.
1ـ إقبال الأعمال، السيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر الحسيني المعروف بابن طاووس (ت664هـ)، تحقيق: جواد القيّومي الأصفهاني، الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي، قم المقدّسة، الطبعة الأُولى، ١٤١٤هـ.
2ـ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (معاصر)، طبعة جديدة منقّحة.
3ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار، محمد باقر المجلسي (ت1111هـ)، الناشر: مؤسّسة الوفاء، بيروت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 1403هـ/1983م.
4ـ التوحيد في القرآن، الشيخ عبد الله الجوادي الآملي، دار الصفوة، ٢٠٠٩م.
5ـ التوحيد، أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، تصحيح وتعليق: علي السيّد هاشم الحسيني الطهراني، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدّسة.
6ـ التوحيد، الشيخ مرتضى مطهري (ت1979م)، دار المحجّة البيضاء، الطبعة الثانية، ٢٠٠٩م.
7ـ سيرة ابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار (ت١٥١هـ)، تحقيق: محمد حميد الله.
8ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت393هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايّين، القاهرة، الطبعة الأُولى، ١٩٥٦م، الطبعة الرابعة، ١٤٠٧ هـ /١٩٨٧م.
9ـ الصحيح من سيرة النبي الأعظم‘، السيّد جعفر مرتضى العاملي (ت1441هـ)، الطبعة الرابعة، ١٤١٥هـ/١٩٩٥م.
10ـ الصحيفة السجّادية، تحقيق: السيّد محمد باقر الموحّد الأبطحي الأصفهاني، الطبعة الأُولى، ١٤١١هـ.
11ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، جمال الدين أحمد بن علي الحسيني المعروف بابن عنبة (ت٨٢٨هـ)، الطبعة الثانية،١٩٦١م.
12ـ العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥ه)، تحقيق: الدكتور مهدى المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي، الناشر: مؤسّسة دار الهجرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ه.
13ـ عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي (من أعلام القرن السادس الهجري)، تحقيق: حسين الحسني البيرجندي، الناشر: دار الحديث، قم المقدّسة، الطبعة الأُولى.
14ـ القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت٨١٧هـ).
15ـ الكافي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي (ت٣٢٨ أو ٣٢٩هـ)، تعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران بازار سلطاني، الطبعة الثالثة.
16ـ كامل الزيارات، الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمّي (ت368هـ)، تحقيق: الشيخ جواد القيّومي، مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأُولى، ١٤١٧هـ، ومؤسّسة نشر الفقاهة.
17ـ لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري المعروف بابن منظور (ت711هـ)، نشر أدب الحوزة، قم ـ إيران، ١٤٠٥هـ.
18ـ اللهوف في قتلى الطفوف، السيّد رضي الدين علي بن موسى بن جعفر الحسيني المعروف بابن طاووس (ت664هـ)، الناشر: أنوار الهدى، قم المقدّسة، الطبعة الأُولى، ١٤١٧هـ.
19ـ المزار، محمد بن مكّي العاملي الجزيني (الشهيد الأوّل) (ت٧٨٦هـ)، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي#، الطبعة الأُولى، ١٤١٠هـ.
20ـ مستدرك الوسائل، الميرزا حسين النوري الطبرسي (ت١٣٢٠هـ)، تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم المقدّسة، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨م.
21ـ مقتل الحسين×، السيّد عبد الرزاق المقرّم (ت1391هـ)، دار الكتب الإسلامية، ١٩٥٦هـ.
22ـ مَن لا يحضره الفقيه، أبو جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القمّي المعروف بالشيخ الصدوق (ت٣٨١هـ)، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدّسة.
23ـ موسوعة الإمام الحسين في الكتب والسنّة، محمد الريشهري (ت2022م)، مؤسّسة دار الحديث، قم المقدّسة، ١٣٨٩هـ.ش.
24ـ موسوعة العقائد الإسلامية، محمد الريشهري (ت2022م)، تحقيق ونشر: مؤسّسة دار الحديث، قم المقدّسة، 1425هـ.
25ـ موسوعة كلمات الإمام الحسين×، لجنة الحديث في معهد باقر العلوم×، دار المعروف للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، 1416هـ/1995م.
26ـ ميزان الحكمة، محمد الريشهري (ت2022م)، تحقيق ونشر: دار الحديث، قم المقدّسة، الطبعة الأُولى، 1375هـ.ش.
27ـ الميزان في تفسير القرآن، العلّامة السيّد محمد حسين الطباطبائي (ت1402هـ)، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم المقدّسة.
28ـ نهج البلاغة، تحقيق: محمد عبدة مفتي الديار المصرية سابقاً (ت1323هـ)، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، الطبعة الأُولى، ١٤١٢هـ.
29ـ ينابيع المودّة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت1294هـ)، تحقيق: السيّد علي جمال أشرف الحسيني، الناشر: دار الأُسوة للطباعة والنشر، الطبعة الأُولى، ١٤١٦ه.
[1] اُنظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: ج4، ص527.
[2] اُنظر: المصدر السابق.
[3] الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين: ج3، ص281.
[4] الفيروز آبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط: ج1، ص344.
[5][5] البقرة: الآية30.
[6] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص194ـ 195.
[7] مطهري، مرتضى، التوحيد: ص13.
[8] اُنظر: جوادي آملي، عبد الله، التوحيد في القرآن: ص١٦٥.
[9] اُنظر: الريشهري، محمد، موسوعة العقائد الإسلامية: ج3، ص365ـ415.
[10] آل عمران: الآية64.
[11] الأنبياء: الآية٢٢.
[12] يونس: الآية3.
[13] السجدة: الآية11.
[14] الزمر: الآية44.
[15] النازعات: الآية5.
[16] اُنظر: الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ج١٩، ص٣٧٧.
[17] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج1، ص509.
[18] الأعراف: الآية 180.
[19] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص144.
[20] الأعراف: الآية180.
[21] يوسف: الآية160.
[22] الصدوق، محمد بن علي، التوحيد: ص324.
[23] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص376.
[24] البقرة: الآية٣٠.
[25] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج17، ص195.
[26] ابن إسحاق، محمد، سيرة ابن إسحاق: ج1، ص1ـ 2.
[27] الأحزاب: الآية6.
[28] آل عمران: الآية68.
[29] نهج البلاغة (تحقيق محمد عبدة): ج3، ص33.
[30] الكليني، محمد يعقوب، الكافي: ج1، ص470.
[31] الريشهري، محمد، ميزان الحكمة: ج1، ص410.
[32] المصدر السابق.
[33] سورة يس: الآية٧٠.
[34] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص375.
[35] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج4، ص574.
[36] الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص595.
[37] آل عمران: الآية٥٢.
[38] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص388.
[39] المصدر السابق: ص385.
[40] المصدر السابق: ص390.
[41] الميرزا النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص222.
[42] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص326.
[43] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص409.
[44] المصدر السابق: ص376.
[45] المصدر السابق: ص440.
[46] ابن عنبة، أحمد بن علي، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص356.
[47] الليثي الواسطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ: ص317.
[48] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص367.
[49] ابن طاووس، علي بن موسى، إقبال الأعمال: ج2، ص66.
[50] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص295.
[51] آل عمران: الآية ١٤٦.
[52] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص373.
[53] الصدوق، محمد بن علي، الأمالي: ص177.
[54] القندوزي الحنفي، سليمان بن إبراهيم، ينابيع المودّة لذوي القربى: ج3، ص82.
[55] المقرّم، السيّد عبد الرزاق، مقتل الحسين×: ص343.
[56] لجنة الحديث في معهد باقر العلوم، موسوعة كلمات الإمام الحسين×: ص650.
[57] العاملي (الشهيد الأوّل)، محمد بن مكّي، المزار: ص42.
[58] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص402.
[59] العاملي (الشهيد الأوّل)، محمد بن مكي، المزار: ص181.
[60] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج84، ص341.
[61] فاطر: الآية28.
[62] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص325.
[63] نهج البلاغة (تحقيق محمد عبدة): ج4، ص77.
[64] يونس: الآية٦٥.
[65] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص369.
[66] العاملي (الشهيد الأوّل)، محمد بن مكّي، المزار: ص42.
[67] الأنعام: الآية ١٦٢.
[68] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329.
[69] البقرة: الآية٢٠٥.
[70] البقرة: الآية٢٠٧.
[71] النحل: الآية١٢٥.
[72] التوبة: الآية١٢٣.
[73] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص371.
[74] المصدر السابق: ص376.
[75] المصدر السابق: ص378.
[76] العاملي (الشهيد الأوّل)، محمد بن مكّي، المزار: ص42.
[77] الصدوق، محمد بن علي، مَن لا يحضره الفقيه: ج2، ص595.
[78] نهج البلاغة (تحقيق محمد عبدة): ج1، ص37.
[79] الزخرف: الآية ٢٥.
[80] الأنعام: الآية ١٢٤.
[81] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص325.
[82] الزمر: الآية 3.
[83] البقرة: الآية 40.
[84] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج١٢، ص270.
[85] ابن طاووس، علي بن موسى، اللهوف في قتلى الطفوف: ص38.
[86] العاملي، السيّد جعفر مرتضى، الصحيح من سيرة النبي الأعظم ‘: ج٧، ص٣٥٦.
[87] نهج البلاغة، (تحقيق: محمد عبده): ج2، ص١٦١.
[88] الصحيفة السجّادية، (تحقيق: السيّد محمد باقر الموحّد الأبطحي الأصفهاني): ص٤١٨.
[89] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج٤، ص٥٧٦.
[90] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص٤٠١.
[91] المصدر السابق: ص371.
[92] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج58، ص129.
[93] البقرة: الآية 179.
[94] الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج1، ص433.
[95] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص409.
[96] الميرزا النوري، حسين، مستدرك الوسائل: ج11، ص80.
[97] فاطر: الآية 8.
[98] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص49.
[99] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج1، ص445.
[100] أبو مخنف، لوط بن يحيى، مقتل الحسين: ص106.
[101] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي: ج2، ص83.
[102] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص394.
[103] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص376.